حكاية الصديقتين اللدودتين (السينمارواية وتنافس الفنون)
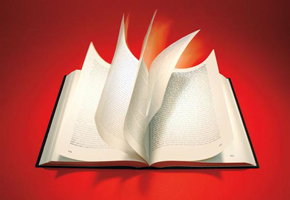
روزا ياسين
في كتابه “أن نقول الشيء نفسه تقريباً” يحاول الكاتب الإيطالي أمبيرتو إيكو أن يتكلم باستفاضة عن الترجمة عامّة، وعن الترجمة الإنترسيميوتيكية خاصة، وذلك في أحد أجزاء ذلك الكتاب. والترجمة الإنترسيميوتيكية تعني، في أحد تفسيراتها، انتقال الفكرة والتعبير من جسد كتاب إلى جسد فيلم، بمعنى تحويل النص السردي إلى نص بصري. وهو يرى أن التغييرات محتومة في هذا الانتقال (التقمّصي)، ولكنها تغييرات مثمرة وغنية في معظم الأحيان، فما يمكن أن يكتمه الكتاب يقوله الفيلم، والعكس صحيح أيضاً. إنهما يتكاملان بشكل ما في نقل صورة عما يريد المبدع قوله، أو عما يمكن أن يقال.
رغم أقواله تلك فقد رفض أمبيرتو إيكو إعادة التجربة التي خاضها مع المخرج الفرنسي جان كلود أنّو حين عمل على نقل كتابه الأشهر : “اسم الوردة” إلى السينما. فقد أقرّ بأنّه وجد الأمر مغامرة مسلّية، لكنه يبرّر رفضه تحويل كتبه الأخرى إلى السينما بأن نقل رواية من مئات الصفحات إلى عمل سينمائي يستغرق ساعتين أو ثلاثا فيه إجحاف كبير للعمل الروائي. على هذا يقترح أن تؤخذ طبقة من الرواية ويتم العمل عليها سينمائياً، وليس بالضرورة أن يأخذ الفيلم على عاتقه فرد الرواية كاملة، كأن الأمر أشبه بمسؤولية أخلاقية تطالب بها السينما تجاه النص الروائي.
ربما كان من الغني النظر إلى الأمر باعتباره إيحاء فنّ إلى فنّ آخر، وكأن ما يحدث أشبه بتخاطر فنّي بين الأجناس الإبداعية، أو النظر إلى السينما باعتبارها رواية بصرية مثلاً، ويبدو أنّ الصفة الانتهازية لم تعد حكراً على الرواية الحديثة فحسب، فالسينما اليوم تحاول أن تلعب اللعبة ذاتها التي سبق واستخدمتها الرواية الحديثة مع بقية الفنون السابقة أو المعاصرة لها، حين سرقت الكثير من تقنيات الشعر والمسرح والفن التشكيلي والسينما ابتداء بالاقتضاب والمونتاج ثمّ المشهدية والتأثير البصري وليس انتهاء بالحوارية والتقطيع النصي. والسينما اليوم تحاول سرقة الرواية لتوظيفها في بناء جسدها، أو لحقن تصورات جديدة في مخيالها السينمائي. ورغم ما قد يبدو من خيانة السينما للنص الروائي إلا أننا لا نستطيع إغفال الفائدة الإعلامية التي وهبتها السينما للرواية في التسويق الجماهيري، الأمر الذي لم تقدّمه الرواية للسينما مطلقاً. فالفيلم يهب الكتاب فرصاً أكبر لتجاوز حدود الزمان والمكان، فيما كانت الرواية الحديثة مصرّة على أن تقاسم السينما جماهيريتها في العقود الماضية. هذا إذا استثنينا الكثير من الأفلام الهوليودية التي يبدو أن هوس الإبهار البصري يقود نجوميتها.
يمكن أن نتذكر الكثير من الروايات التي تحوّلت إلى أفلام ناجحة في السنوات الماضية والتي من الصعب حصرها كالعطر لباتريك زوسكيند، الساعات لمايكل باكنغام، إلى فيلم كاتسبي العظيم عن رواية الأميركي سكوت فتزجرالد، إلى بيت الأرواح لإيزابيل الليندي. كما اقتبست رواية بول أوستر موسيقى الحظ للسينما، وحوّل ألان كورنو روايات أنطونيو تابوكي إلى السينما ومنها روايته: ليالي هندية. لكن آراء كتاب الرواية تتباين للغاية بشأن تحويل نصوصهم إلى السينما، كما تتباين آراء السينمائيين بخصوص استخدام السينما للرواية. وربما لا تكمن المشكلة في الفرق الكبير بين لغة السيناريو ولغة السرد الروائي فحسب، بل في نوعية المتلقي الذي ينتجه كل فن من الفنين. فلا يمكننا إغفال أن حرية التأويل وتفكيك الدلالات اللامتناهية في الرواية، وهي ليست حرية مطلقة أصلاً بسبب خضوعها لمنطق النص نفسه، تنتفي في الفيلم إلى حدّ كبير. ذلك أن السينما تضع الكثير من القيود على تخييل القارئ حين تتخيّل الكثير بدلاً عنه. وربما كان الأدب يولد قرّاءً أكثر إبداعية وخيالاً من “قرّاء” السينما، ويحوّل “قرّاء” السينما إلى متلقين سلبيين تغمرهم الصور المتلاحقة كأنهم في مغطس. ونستطيع أن نرى بأن السينما تكاد تلغي فرصة أن يتحول القارئ إلى كاتب ثانٍ، وتنتفي الفسحة التي يستطيع ذلك القارئ أن يشارك فيها الكاتب بإعادة كتابة النص وقراءة شخصياته وتحسّس لغته. ولعل الفرق الرئيسي بين الرواية والفيلم أن قارئ الفيلم مجبر على تلقي القصة وقبولها مثلما تفرضها رؤية المخرج، فثمة الكثيرين ممن يرون أن السينما تقوّض ذاك الشعور الذي تخلقه الرواية بأنك تعيش تجربتك الذاتية معها، في السينما لا يشعر الكثيرون بأنهم يخوضون تجربة ذاتية جديدة لم يختبروها قبلاً، وربما كان الأمر يتعلق بكون الفيلم يمثّل قراءة واحدة للرواية مسبوكة من وجهة نظر متلقي واحد. أما قارئ الكتب فلديه فسحة حرية يمكن لخياله أن يسرح فيها ويضيف إليها ما شاء من التفاصيل والإمكانات السردية.
من جهة أخرى تستطيع المؤثرات الهائلة التي تتمتع السينما بها أن تهب النص الروائي عوالم أخرى لا توجد في الكتابة كالفضاء السينمائي والإيقاع والموسيقى والحركة، كل ذلك يستطيع أن يمنح النص بعداً وأفقاً جديدين. كما إننا لا نستطيع أن نغفل ما تراكمه السينما في ذاكرتنا من الثراء البصري الهائل الذي يخزّن في لاوعينا، وربما كانت السينما تعلمنا أن نروي القصص بشكل أكثر تماسكاً وتكثيفاً، وأن نتخيل أكثر حركة الشخصيات وطقوسها.
تبدو السينما والرواية اليوم صديقتين لدودتين تحفزان بعضهما على التطور، ويشوب علاقتهما شيء من الغيرة والتنافسية والحبّ التي تشوب علاقة الأنداد، لكن السؤال الجدير بالطرح هل يستطيع فن حديث لم يمرّ وقت طويل على بلوغه المائة عام كفنّ السينما أن ينافس فناً عريقاً كالرواية انقضت قرون وقرون وهو يختبر الحياة بتنوعاتها؟ وربما كان السؤال الأهم إلى أي حدّ ستتخلص السينما من عقدة الأصغر تجاه الأكبر وتتخلّص الرواية من عقدة الأكبر تجاه الأصغر كي ينتج فنّ جديد له اعتداده الخاص، وربما أمكننا أن نطلق عليه الرواية السينمائية أو السينمارواية؟
موقع الآوان




