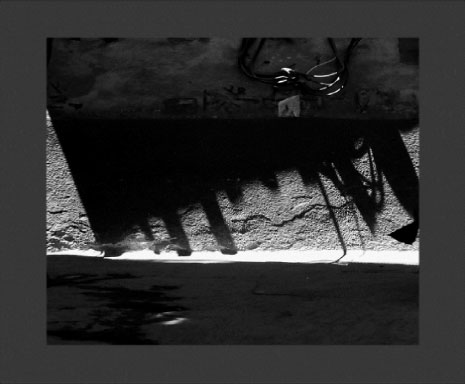عندما تكتب يرتفع البحر

يُعتبر قسطنطين بيتروس كڤافيس من أهم شعراء اليونان الحديثة. ولد في الاسكندرية عام 1863 حيث كان والده يمارس التجارة وغيرها من الأعمال والمشاريع والصفقات، وأمضى فيها معظم سنوات عمره، حتى وافته المنية عام 1933. عاش في عزلة تامة. لم يغادر مدينته، برغم الدعوات الكثيرة التي وُجّهت اليه من الاوساط الادبية في اثينا. ترك مجموعة شعرية من مئة وأربع وخمسين قصيدة، لم ينشر منها في حياته سوى القليل في بعض المجلات. كان يكتب في بطء شديد، مُخضعاً قصيدته للتنقيح والتصفية باستمرار حتى يشعر بالرضا، فجاء شعره الذي امتاز بالايجاز، ذا نسيج فريد في الشعرية اليونانية الحديثة، في كلمات من الأسهل، والأبسط، والأعذب. يقول في هذا الصدد: “على فنان الكلمة ان يجمع بين الكلمة العذبة والحية”. وقد زخر هذا الشعر باللحظات المعيشة، في ضعف الانسان، وتجاربه، وخوفه من الموت وتوقه اليه، مدوناً بسخرية الحكيم الحليم ملامح الانسان المقهور في قبضة طغاة السياسة والدين والأخلاق، ومستغرقاً في تأمل دائم في تقلبات العالم الهيليني، منذ فتوحات الأسكندر حتى الميديين في العهد الڤيكتوري الذين احتلوا مدينته ومسقط رأسه. وقد حاول كڤافيس بذلك، أن يحيي الماضي في الحاضر، وان يمزج الواحد بالآخر، مطابقاً هويات مقهوري الأمس على تلك التي في ايامنا. وهكذا بات التراث الأسكندري، اليوناني – الروماني والبيزنطي، وكل التراكمات المعرفية، مصفّاة عبر إحساسه، مما أكسبه أن يُنعت بشاعر التاريخ، بخلاف سابقيه الغنائيين. وهو يقول أيضاً عن نفسه في غير مكان: “أنا شاعر الشيخوخة”. وفي ملاحظة صائبة لجورج سيفيريس عنه تقول: “إن شعر كڤافيس، بدءاً من 1910، يجب أن يُقرأ ويُقوِّم، لا كسلسلة من القصائد، بل كقصيدة واحدة مستمرة، وضع حداً لها الموت”.
II
في الجيل اللاحق لكڤافيس، يحتل جورج سيفيريس (1900 – 1971) مركزاً متقدماً ومرموقاً في الادب اليوناني المعاصر. حاز عام 1963 اول جائزة نوبل تُمنَح لهذا الأدب. شعره يعكس الأزمة العميقة التي نجمت على اثر نكبة آسيا الصغرى (1920)،

محاولاً في تأمله الخرائب او بحثه عن توازن جديد، ان يقيم، عبر تشاؤمه ويأسه المستكين، حواراً مع التاريخ. واذا كان سيفيريس، قد تلاقى والشعر الصافي أو ت. س. إليوت، في بعض الأحايين، وأن يصطف الى جانب الطليعيين في أوروبا، فهو لم ينفصل قط عن رؤياه الهيلينية في الاساس: نحن على صلة دائمة بأوليسيس مقاوم البطل، وبدون إيتاكا، التعِب من الأسفار والحروب، الذي لا يحلم الا بالعودة الى داره، فردوسه الضائع وهويته معاً. كان له نشاط في ترجمة الشعر، فنقل الى اليونانية: “الأرض اليباب”، وقصائد أخرى لأليوت، وايضاً لهنري ميشو، وبول إيلوار، وبيار – جان جوڤ، وعزرا پاوند، ولورنس دوريل، ووليم بتلرييتس. كما كان له نشاط بارز في النقد، بما له من معرفة واسعة بأسرار الشعر وضروبه في بلده وفي العالم. وقد اهتم خصوصاً بالشعراء الذين يقدرهم. لكنه في هذا النقد الذي جاء تكملة لشعره، ولا يقلّ عنه قيمة، لم يشأ أن يبرهن، أو يجادل، بل أن يحب ويفهم ويشرح. وعليه، فليس من قبيل المصادفة، أن يكون سيفيريس ذا تأثير مزدوج على الأدب اليوناني المعاصر، شعراً ونثراً. التحق شاعرنا بالسلك الديبلوماسي منذ عام 1926 حتى وفاته. وقد عرفته بيروت عام 1952 سفيراً فيها لأربعة أعوام.
من: كڤافيس
الرغبات
الرغبات التي عبرت من دون ان تحقَّق،
دون ان تنعم بإحدى ليالي المتعة،
ولا بأحد أصباحها المشرقة،
تًشبه جثثاً جميلة لم تعرف الشيخوخة،
وقد أودعت في ضريح فخم، مع النحيب،
والورود عند رؤوسها،
وعند أقدامها الياسمين.
أصوات
أصوات عزيزة مثالية، اصوات أولئك الذين ماتوا،
أو اولئك الذين هم، بالنسبة الينا، ضائعون كالأموات.
أحياناً تتكلم في احلامنا، وأحياناً
تسمعها عقولنا، في أفكارها العميقة.
إنها تستحضر لنا في لحظة، صدى الشعر الأولي
في حياتنا، كموسيقى بعيدة تتلاشى في الليل…
صلاة
لقد ابتلعت الأمواج بحّاراً في أعماقها.
أمه التي لم يبلغها الخبر الشؤم بعد، كانت
تُشعل شمعة طويلة
أمام صورة السيدة العذراء، كي يعود اليها
ابنها سريعاً، ويحظى بجو صاف،
وراحت تُرهف السمع للريح في قلق،
لكن الأيقونة كانت تصغي الى صلاتها في حزن ووقار،
عارفة أن ابنها لن يعود.
الدرجة الأولى
تشكّى يوماً الشاعر الشاب أفمينيوس الى ثيوقريطس:
– منذ عامين وأنا أكتب، غير أني لم أنجز سوى قصيدة غزلية واحدة.
يبدو لي أن فن الشعر سلّم لا نهاية له، وأني ما زلت على الدرجة الاولى، واحسرتاه! لن أصعد أبداً الى أعلى.
– كلمات باطلة! وتجديف! أجابه ثيوقريطس. عليك ان تفخر وتفرح بأنك ارتقيت تلك الدرجة الاولى. فأن تبلغها، ليس بالقليل. وأن تنجز ما انجزت لهو شرف عظيم. فلكي تتمكن من وضع قدمك على تلك الدرجة، المتعذرة كثيراً على شخص عادي، يجب أن تكون “مدينة المثُل” قد قبلتك مواطناً. وإنه لامتياز تصعب حيازته، لأن الحكام الجالسين في ساحتها، يفضحون في الحال، غير الجديرين، فأن تبلغ تلك الدرجة ليس بالقليل. وأن تنجز ما أنجزت لهو شرف عظيم.
عجوز
في مؤخرة مقهى صاخب، جلس عجوز محنياً على منضدة، وقد بسط أمامه صحيفة كرفيق وحيد.
وأخذ يفكر، بدءاً من أعماق شيخوخته المقيتة، في ضآلة ما تمتع به في تلك السنين العابرة، إبان كان يملك القوة والوسامة والفصاحة.
يعرف انه شاخ كثيراً، يشعر بذلك، ويراه. ولكن يبدو له أنه في الأمس القريب كان فتياً. فيا لها من مسافة قصيرة!
كان يومها جد ساذج (يا للحماقة!)، كان يصيخ للحكمة الكاذبة التي كانت تهمس في أذنه: “غداً… لديك متسع من الوقت!”
ويتذكر الميول المكبوحة، والتضحيات بأفراح لا تحصى. والآن، كل مناسبة ضائعة تسخر بحكمته الغبية.
لكن تلك الأفكار والذكريات المتضافرة على الرجل العجوز تُثقل عليه، فيستسلم للنوم متكئاً على منضدة المقهى.
شموع
تنتصب الأيام الآتية أمامنا كصف من الشموع الصغيرة المشتعلة، شموع صغيرة ذهبية، حارّة، ونابضة.
وتمكث الأيام الماضية وراءنا، في صف حزين من الشموع المطفأة. والأقرب عهداً منها، لا تزال تدخّن، باردة، ذائبة، محنيّة الرأس.
لا أريد ان اراها؛ فمرآها يشجيني.
ويؤذيني أن اتذكر نورها الاول فأحوّل نظري
الى شموعي المشتعلة أمامي.
لا أحب ان التفت ولا أن أشاهد في رعب،
كيف بسرعة، يستطيل الصف المعتم، وكيف، بسرعة،
تتكاثر الشموع المطفأة.
رتابة
يوم رتيب، يتبعه يوم آخر رتيب مماثل.
كل الامور ستحدث، وستتكرر ثانية.
أنات متشابهة تقترب منّا وتبتعد.
يمضي شهر، ويأتي بآخر. المستقبل
يسهل استقراؤه، انه من نسيج
ملل الأمس. والغد ليس أبداً بغد.
في انتظار البرابرة
– ماذا ننتظر، محتشدين هكذا في الساحة؟
– البرابرة سيصلون اليوم.
– ولِمَ مجلس الشيوخ في عطلة؟ ولمَ الشيوخ لا يسنّون القوانين؟
– لأن البرابرة سيصلون اليوم. وأي قوانين يسنّ الشيوخ؟ فحين يحضر البرابرة يقومون هم بذلك.
– لِمَ يستيقظ امبراطورنا مبكراً، ويجلس في أبهة تحت ظلة عند أبواب المدينة، وعلى رأسه التاج؟
– لأن البرابرة سيصلون اليوم. والامبراطور يتأهب لاستقبال قائدهم؛ كذلك أعدّ خطبة يُنعم عليه فيها بالرتب والألقاب التشريفية.
– لمَ يزدانون بأساور من الجَمَشْت، وخواتم براقة من الزمرد؟ ولمَ يحملون صولجاناتهم النفيسة، والمرصّعة بدقة؟
– لأن البرابرة سيصلون اليوم، وهذه الأشياء الثمينة تُبهر البرابرة.
– لمَ خطباؤنا المفوّهون لم يأتوا لألقاء خطبهم البليغة كالعادة؟
– لأن البرابرة سيصلون اليوم، وهم لا يقدرون لا العبارات الرنانة ولا الخطب الطويلة.
– ولمَ هذا القلق المفاجئ والاضطراب؟ يا للعجب، كيف غدت الوجوه عابسة! ولمَ الشوارع والساحات تفرغ بسرعة زائدة؟ ولمَ يعود الجميع حزانى الى بيوتهم؟
– لأن الليل قد هبط، ولم يصل البرابرة. والذين قدموا من الحدود يقولون أن لا أثر للبرابرة…
والآن، ماذا سنفعل بدون برابرة؟
كان هؤلاء على الأقل، حلاً من الحلول.
إيثاكا
عندما تُزمع الرحيل الى إيثاكا،
تمنّ أن تكون الطريق طويلة،
غنية بالمغامرات والتجارب.
لا تخشَ الليستريغونيين والسيكلوبات، ولا غضب نبتون.
لن يعترضك أحد منهم، ما دامت أفكارك سامية،
ولم تخامر جسدك وروحك سوى الأحساسات الصافية.
لن تلقى الليستريغونيين والسيكلوبات ونبتون الساخط، إلا اذا حملتهم في ذاك، ولم يضعهم قلبك أمامك.
تمنَّ أن تكون طريقك طويلة، وأصباح الصيف كثيرة، حيث (ويا لها من متعة!) ستدخل موانئ تشاهَد للمرة الأولى.
توقف عند الأسواق الفينيقية، واقتن البضائع الرائعة: من محار، ومرجان، وعنبر، وأبنوس، وعطور تثير الدوار من كل صنف.
وعَرّجْ على مدن مصرية عديدة، واقتبس المعرفة من حكمائها.
لتكن إيثاكا دوماً في فكرك.
ليكن هدفك النهائي، الوصول اليها، ولكن
لا تختصر رحلتك:
من الأفضل أن تدوم أعواماً طويلة،
وأن لا تبلغ جزيرتك في الأخير،
إلا وقد طعنت في السن،
غنياً بما كسبته في طريقك،
دون أن تتوقع من إيثاكا أي إثراء.
لقد منحتك إيثاكا الرحلة الرائعة:
لولاها لما كنت بدأت مشوارك.
ولا شيء آخر عندها لتُعطيك.
وحتى لو وجدتها بائسة، فهي لم تخدعك.
فبما أنك قد أصبحت حكيماً بعد كل تلك التجارب، أظنك فهمت أخيراً ما تعنيه “الأيثاكات”؟
(Constantin Cavafy: Poèmes, Trad, M. YourCenar, NRF)
من سيفيريس
هاي – كاي
إرمِ في البحيرة
قطرة خمر واحدة
تُظلم الشمس.
*
الكراسي فارغة
لقد عادت النصب
الى المتحف الآخر.
*
هل هو صوت
أصدقائنا المتوفين
أم صوت الغراموفون؟
*
لبستُ ثانية
أوراق الشجرة،
وأنت، تثغين.
*
كيف نجمع
ألوف البقايا الطفيفة
لكل إنسان؟
ما بها دفّة المركب؟
فالمركب يرسم دوائر
وما من نًورس.
*
ليس لها عينان.
والأفاعي التي تمسك بها
تلتهم يديها.
*
في هذا العمود
ثقب. هل ترى فيه
برسيفون؟
*
عندما تكتب
ينقص الحبر
ويرتفع البحر.
*
هذا الجسد الذي تمنّى أن يزهر كغصن،
ويحمل الثمار، ويصبح ناياً في الجليد،
قد دفنه الخيال في خشرم ضاج،
كي يعبر زمن الموسيقى ويختبره.
هرَب
ذلك ما كانه حبُّنا؛
كان يمضي، ويعود جالباً لنا
جفناً منخفضاً، بعيداً للغاية،
وابتسامة جامدة، ضائعة
في عشب الصباح؛
ومحارة غريبة كانت تحاول
ذاتنا أن تحل رموزها في كل وقت.
ذلك ما كانه حبّنا، كان يتقدم في بطء
عشوائياً بين الأشياء المحيطة،
كي يشرح لماذا نرفض الموت
بكل الشغف؟
لقد تعلّقنا عبثاً بقامات أخرى،
وضممنا أعناقاً أخرى، ومزجنا بولع
أنفاسنا بأنفاس أخرى،
وأطبقنا عبثاً عيوننا، ذلك ما كانه حبّنا…
لا شيء سوى الرغبة جد العميقة،
في وضع حدٍّ لهرَبنا.
العجوز
تقاطر الكثير من القطعان، والكثير من الفرسان
الفقراء والأغنياء – بعضهم جاء
من القرى البعيدة، أمضى
الليل في الخنادق، أشعل
النيران لطرد الذباب – ألا ترى
الرماد؟ ثمة جروح مستديرة وسوداء، التأَمت.
إنه مغطّى بالندوب، كالطريق.
وبعيداً في البئر الجافة، كانت تُطرح
الكلاب الكلبى. إنه بلا عينين، مغطّى
بالندوب، إنه بلا ثقل: الريح تعصف.
إنه لا يميز شيئاً، يعرف كل شيء،
غِمد زيز فارغ على شجرة جوفاء.
إنه بلا عينين، ولا حتى يدين، يعرف
الفجر والغسق، يعرف النجوم،
دمها لا يغذيه، إنه ليس حتى
ميتاً، لا ينتمي الى جنس، لا يموت،
وهكذا سوف يُنتسى، بلا ذرّية.
أظفاره التعبى من اصابعه
ترسم صلباناً على ذكريات فاسدة،
فيما الريح المضطربة تعصف. يتساقط الثلج.
رأيت الجليد حول الوجوه.
رأيت الشفاه الرطبة، الدموع الجامدة
في أمواق العيون؛ رأيت غَضَنَ
الألم قرب الأنوف والجهد
في عروق اليد؛ رأيت الجسد يهتدي الى نهايته.
ذلك الظل ليس وحيداً. إنه مشدود
الى ذلك العود الذي لا يلتوي أبداً،
ولا يمكنه حتى أن ينخفض ليتمدد.
كان النعاس يوزع أجزاء هيكله
بين الأولاد أثناء اللعب.
يأمرهم كتلك الأغصان اليابسة
التي تتكسّر عندما يهبط الليل،
وتستيقظ الريح في الأودية،
يأمر ظلال البشر،
لا الانسان في ظلّه
الذي لا يسمع سوى أصوات الارض
والبحر الخافتة، هناك حيث يلتقيان
بصوت القدر. إنه يقف مستقيماً،
على الشاطئ، بين أكداس العظام،
بين أكوام الاوراق اليابسة،
كسلّة قصب فارغة تنتظر
ساعة الاحتراق.
ملاحظات في أسبوع
الاثنين
بين الزنابق المحنيّة يرقد العُمي،
جمعٌ من العُمي، والزنابق تنحني
محترقة بجليد الفجر.
(أذكر تلك المحتجزة في جو دافئ،
في شتاء غير بعيد.
الحياة تكفي).
(اسخيلوس: أغاممنون)
ثمة أدوات تالفة، تُستعمل كوسادة،
فونوغرافات مُقعدة،
هارمونيكات مثقوبة،
هارمونيومات مُنهكة.
هل ماتوا؟
لا نتبيّن بسهولة أعمى ساكناً.
أحياناً تنشط أحلامهم، لذا أقول
إنهم يرقدون.
من كل جهة تومئ لي ثياب ملاك مسمَّرة
على المنازل.
النهر لا يجري، نسي البحر.
لكن البحر موجود، ومن سيستنفده؟
العُمي يرقدون،
يجري الملائكة العراة في عروقهم،
يشربون دماءهم، ويمنحونهم الحكمة.
والقلبُ بعينيه المخيفتين يتوقع اللحظة
التي سينضب فيها.
أنظر الى النهر،
زوابع خفيفة تعبر تحت الشمس الضعيفة.
لا شيء بعد، النهر ينتظر.
فارأف بأولئك الذين ينتظرون.
لا شيء بعد، يكفي ذلك لهذا اليوم.
الخميس
رأيتها تموت غالباً؛
طوراً وهي تبكي بين ذراعيَّ،
وتارة بين ذراعي غريب،
وتارة أخرى وحيدة وعارية:
هكذا عاشت بالقرب مني.
حالياً، أعرف أن لا شيء لا يوجد في الأبعد،
وأنتظر،
فإن أكن حزيناً فتلك مسألة شخصية،
كتلك المشاعر نحو الاشياء البسيطة
التي تجاوزها الزمان – كما يُقال.
ورغم ذلك ما زلتُ أتحسّر
لأني لم أُصبح بدوري (وكم تمنيت)
كتلك العشبة التي شاهدتها تنبت
في إحدى الليالي قرب صنوبرة؛
ولأني لم ألحق بالبحر
في ليلة غير بعيدة حين انحسرت أمواجه
شاربة بهدوء حمازتها،
ولأني لم أفهم حين كانت أناملي تلعب
مع الطحالب الفاترة.
فأيّ مجدٍ يقيم بعد بين يدي الانسان؟
حتماً، وبتثاقل، كل تلك الاشياء ولّت
كمثل تلك القوارب ذات الاسماء الباهتة
Hélène de Sparte, Tyran, Gloria Mundi
التي تعاقبت تحت الجسور، بعيداً من المداخن،
وفي الكوثل والجؤجؤ
رجلان منحنيان وعاريان حتى الخصر.
لقد ولّت، وأنا لا أتبيّن شيئاً،
في ضباب الصباح، تكاد تُلمَح
الخرافُ التي تجترّ ملتفّة على بعضها، نكاد
في الليل نتبيّن القمر في النهر
الذي ينتظر.
فقط سبع حراب مغروزة
في الماء الساكن وبدون أثر للدم،
وأحياناً، على الارصفة السيئة الاضاءة،
عند قاعدة البرج الأشوص
المرسوم بالطبشور الأحمر والأصفر
يكشف الناصري عن جرحه.
“لا ترموا قلوبكم للكلاب”.
“لا ترموا قلوبكم للكلاب”.
كان صوته يتبدّد في الساعات الدقاقة.
إرادتك، إرادتك، ما أبحث عنها.
الجمعة
كم من مرة، منذ ذلك الوقت، لم أرَ امرأة
تمر أمامي، لا تملك غير عينيها، والشَعر،
والصدر، كغورغون تسافر في البحر،
والريح بينهما كدمٍ أزرق.
السبت
– لم أنسَ شيئاً.
كل شيء في مكانه، ومنسّق،
في انتظار اليد التي تختار.
لكني لم أعثر على سنوات الطفولة
ولا على المكان الذي ولد فيه بطل المأساة
ولا على انطباعاته الأولى،
تلك التي يتذكرها في الفصل الخامس
وهو في غاية البؤس.
وما تبقّى، ها هو، بالتتابع:
أقنعة الاحاسيس الثلاثة الرئيسية،
وتلك الاحاسيس المتوسطة؛
والفساتين المغبونة، الجاهزة للتحرّك،
والستائر، والاضواء؛
وابناء “ميديا” الاموات؛
والسمّ، والمِدية.
في هذه العلبة، هي ذي الحياة، عندما تزمع
أن تصير غير محتملة.
يكفي أن ترهف السمع وستسمعها تتنفّس.
فاحذر أن تفتحها قبل أن تنادي “اليومينيدس”.
وفي القنينة، هوذا حب الجسد؛
وفي تلك القنينة الزرقاء، حب الروح؛
– فحاذر أن تمزجهما –
وفي هذا الدُّرج، قميص “نيسّوس”
(الفصل الخامس، المشهد الثالث)
هل تتذكّر نصّك، في البداية؟
– الحياة تكفي!
هنا، النفير الذي يهدم القصر؛
والملكة تظهر بكل خسّتها،
وقاطع الميكروفونات؛
سوف يستمع اليك حتى تخوم العالم.
فامضِ – حظاً سعيداً!
– “لحظة! من سأكون ومن يجب أن أقتل؟
أولئك الناس الذي ينظرون إليّ،
كيف يعتقدون أن العدالة معي؟
كيف يعتقدون؟
لو كنّا فقط نستطيع أن نحب،
لنقل كما يحب النحل
– وليس كما يحب اليمام –
لنقل كالأصداف
– وليس كما تحب السيرينات-
لنقل كما يحب النمل
– وليس كما يحب شجر الدلب-
ألا تراها إذاً، إنها كلها عمياء!
العُمي يرقدون…”.
ممتاز! يمكنك أن تتابع…
الأحد
حصانان ضخمان، عربة بطيئة، ذلك أو شيء آخر،
وهذا الضجيج تحت نافذتي في الشارع.
قريباً يهبط الليل. زخرف مدخل ما زال يرمقني،
مغطّى بأنصاب مشوّهة.
كم يزن نُصب؟
أفضّل قطرة دم على قدح مليء بالحبر ¶
(Georges Séféris, Poèmes (1933-1955), Mercure de France).
كڤافيس / سيفيريس
(التقديم والترجمة: هنري فريد صعب)
النهار