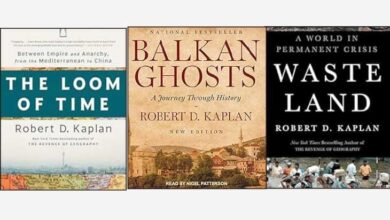التحديق في الهاوية العراقية/ شاكر الأنباري

اشتهرت الثقافة العراقية الحديثة بتركيزها على الأدب، والثقافة عموماً، من شعر وقصة ومسرح وفن تشكيلي وسينما ونقد ومباحث تراثية، لكنها قليلاً ما التفتت إلى الجانب البيئي وعلاقة الطبيعة بالفرد، وخاصة عنصر الماء الذي هو مصدر لكل شيء حي. هل فقدنا حكمة التعامل مع الطبيعة، وهل يمكن استعادة تلك العلاقة الفطرية التي اكتسبها الإنسان من الطبيعة ذاتها؟ يتساءل خالد سليمان في كتابه هذا ويجيب بأن صفحات هذه الدراسة هي جواب على هذا السؤال الذي يعد سؤالاً كونياً اليوم، إنما يحتاجه العراق أكثر من غيره، ذاك أنه من بين البلدان الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي المتمثلة بالجفاف والفيضانات والتصحر.
ثقل الأزمات، السياسية خاصة، جعلنا من النادر أن نلتفت إلى البيئة المحيطة بنا وتحولاتها الكارثية التي لا يعيرها أحد أي اهتمام. ومن يرغب في تلمس ذلك عليه الاحتكاك بالضحايا، الناس القاطنين في الأرياف والأهوار والقصبات الصغيرة، وحتى المدن الكبرى. وإذا كان حمورابي قد عرف بفضيلة شق القنوات والسواقي، وإشادة السدود قبل ما يقرب من 3800 سنة، ليشيد مملكة بابل العظيمة، إضافة إلى سن شريعته الخالدة، فبعد هذا التاريخ البعيد أهمل ورثته، وبجدارة، معظم أراضي الرافدين، فتحولت إلى صحاري وقفار يثور الغبار في آفاقها ويملؤ الصدور بالموت. أهملوها واستثمروا في السرقات، والحروب، والقتل بعضهم لبعض، نكاية بحضاراتهم العظيمة ومنها الحضارة البابلية التي صنعت حمورابي. بهذا المعنى ثمة فجوة حضارية هائلة بين بابل القديمة وعراق اليوم. والعراق بلا ماء سيصبح فضاء لعبور الصواريخ، وأرضا لتصادم الدبابات، وهواء معبأ بحريق النفط والغاز. أين مضت أشجار الرمث والطرفاء، وملايين النخيل، والبساتين التي كانت تحيط بالمدن والبلدات، وحقول البطيخ والرقي، ومزارع الشلب والحنطة والشعير والذرة والسمسم؟ أما تلك السواقي المتشعبة النابعة من الأنهار الغائرة في ثنايا الأرض فقد جفت وماتت. إن وجد الماء تفتقد الكهرباء، وإن وجدت الكهرباء والماء عدمت الأيدي التي تعمل بها، بعدما جنّد الشباب للقتال في الفيافي والقفار وخلف الحدود ابتغاء أهداف غير معروفة لا يعرف منها سوى الفناء. لعب الماء دورا كبيرا في صياغة البعد الروحي للإنسان الرافديني، وترك أثره في أعمال الأدباء المعاصرين مثل محمد خضير، والجواهري، ونعيم شريف، وبدر شاكر السياب، حيث استشهد الباحث ببعض من نصوصهم، قصة وشعرا، مثلما لعب الدور ذاته في التراث الروحي للسومريين، والبابليين، متجليا في القوانين، والأناشيد، والأساطير، والملاحم مثل ملحمة جلجامش، بل كان له دور هائل في العلاقة بين البشر الفانين والأناناكي الخالدين باعتبارهم آلهة سماوية.
لوحة الكتاب تمتد من عشار البصرة وشط عربها نحو الأهوار الجنوبية، مرورا ببغداد العاصمة، وشمالا لتصل أراضي “كرميان” الكردستانية الحارة، جنوبي كركوك والسليمانية، مسقط رأس الكاتب الذي يتذكر داره الفلاحية ببئرها الجافة وشجرة التوت التي زرعها والده لكي تهدي لأطفال القرية ثمارها البيضاء بطعم السكر، وهي لا تبعد كثيرا عن النهير الصغير المعروف “آوسبي”. وضمن برنامجه البحثي المستند على المشاهدة العيانية، وبلغة صحافية استقصائية، يعمد خالد سليمان إلى زيارة هور “الدلمج” الواقع بين محافظة الديوانية والكوت، ليلمس تأثير الجفاف على بيئة الأهوار وما فيها من طيور، وحيوانات، ونشاط إنساني، كصيد السمك، وصناعة الحصران من القصب. ويضيء الكتاب بفصوله الشيّقة، الدور الذي تلعبه النباتات في تنقية الهواء، وامتصاص التلوث الآتي إلى الأهوار من المدن البعيدة عبر نهري دجلة والفرات، وتأثير سياسات دول الجوار مثل إيران وتركيا في البيئة المائية بسبب تحكمهما في الأنهار ومصادر المياه من أراضيهما كدجلة، والفرات، والكارون، والكرخة. ويستند في تقييمه لذلك الواقع على آراء مختصين عراقيين في مجال الموارد المائية والبيئة. وبعين الكاتب الحساسة، يرسم لوحة جميلة لمضايف القصب والبردي، ومسطحات المياه، وغروب الشمس، والطيور المهاجرة، وانبثاقات النجوم على غابات البردي وهي تلطّف صيفا جزءا من لهيب العراق. حيث تصل درجة حرارته بعض السنين إلى خمسين درجة مئوية، ويصبح الخروج من البيت معجزة. وهذه الرحلة تدعو عند قراءتها إلى العجب والذهول، فكيف يقوم باحث كردي عراقي كان مقيماً مع عائلته في كندا، ثم عاد ليستقر في مدينة السليمانية قريباً من مسقط رأسه “كرميان” ليشد الرحال إلى أعماق الهور كي يقدم لوحة ميدانية عن واقع الأهوار وناسها، وطيورها، وهموم نسائها، ونسيج أصابع فلاحيها التي أبدعت عبر التاريخ في بناء أجمل الحضارات العالمية مثل سومر وأكد وبابل؟
لقد كرس الباحث فصلا من فصول الكتاب لتجربة الفلاحة الجنوبية “حليمة السوادي” من ناحية سومر، الواقعة على بعد ثلاثين كلم شمال مدينة الديوانية، فهذه المرأة الجنوبية تعرف تماما ما يجري من تغيرات مناخية مرعبة، هي تراها خلف جدار بيتها وفي رفيف الطيور وأوراق النباتات المزروعة في الفناء. وهي تحاول الوصول إلى أفضل الطرق الحديثة لمتابعة أساليب الزراعة الحديثة، وكل ذلك عبر معرفة علمية لا تتجاوز الابتدائية، ومن خلال تلفون موبايل مربوط بالانترنت. هذه المرأة تعيل عبر عملها الزراعي ثلاث عائلات فقيرة تعتمد على جهدها كلية. حليمة السوادي شرحت بوضوح ما أصاب المناخ في هذه المنطقة، وكيف انعكس التغير في درجة الحرارة على زراعة الخضراوات والشلب والمحاصيل الأخرى. فيوما بعد آخر لم يعد الصيف وقتا للزراعة بسبب ارتفاع حرارته المتواصلة صعدا إلى نهايات أيلول، وهو أمر غير معتاد في الخمسين سنة الأخيرة. “الفاضلية” هي قريتها الصغيرة، لكن ذلك التلفون الصغير جعلها تعيش في قلب العالم ومتغيراته، وما يحدث فيه من كوارث بيئية وأمراض غريبة نتيجة التلوث الشامل الذي لم يصب الفاضلية وناحية سومر والديوانية والعراق وقارة آسيا فقط، بل أصاب الكرة الأرضية برمتها. الأناناكي لم يعد موجوداً، غاب واندثر في عتمة التاريخ، وحلت محله الصواريخ العابرة للقارات، والسفن الفضائية الباحثة عن كوخ للعيش خارج المنظومة الشمسية.
الفجوة التاريخية بين زمن حمورابي الذي اهتم بالطرق، والسقي، والقنوات، والقوانين المنظمة لشؤون البشر، ووقتنا الحاضر، تتضح بشكل مأساوي في الفصل الثامن الذي عنونه خالد بـ”طالبات في مدارس خالية من المياه”، وجاء لوحة كارثية لواقع النساء الريفيات، سواء في كردستان العراق أو المدن العراقية جنوبا وشمالاً شرقاً وغرباً. وهو عن فتيات لا يجدن مرافق صحية في المدرسة، ويضطررن للجوء إلى الجامع القريب، أو الجيران لتنظيف أجسادهن. ونساء يجلبن الماء الصالح للشرب من مسافة عشرة كيلومترات، بعد أن دب الملح في المياه الجارية، وتخلت الوزارات عن مهامها المفترض وجودها كتوصيل المياه العذبة للقرى، والاهتمام بالطرق الريفية الذي يقطعها الطلاب للذهاب إلى مدارسهم، وإيصال الكهرباء إلى البيوت. وهي لوحة تكشف فضائح الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وبرلماناتها، ومؤسساتها، وأوقافها، وقنواتها الفضائية ذات الخطاب الديني الكريه، المشبع بالضغينة والأسن التاريخي وسط عالم قطع شوطا هائلا في التسامح، والعقلانية، وحقوق الانسان. يقول طالب إعدادية تقع وسط الديوانية إن مدرسته تفتقد لأبسط مستلزمات الراحة، إننا ندرس في صفوف لا توجد فيها سوى مراوح تقليدية وهي لا تساعد على التبريد حين تصل درجات الحرارة إلى ما فوق 40 مئوي. وإذا انقطع التيار الكهربائي يلجأ الطلاب الذين لا يقل عددهم عن خمسين طالبا في الصف الواحد إلى تهوية أنفسهم بالكتب والدفاتر المدرسية. تحول السيول والفيضانات دون ذهاب الأطفال إلى المدارس، ولانقطاع التيار الكهربائي آثار جانبية مباشرة على الأنشطة التعليمية ومن بينها المختبرات، ويؤدي اتساع مساحات التصحر الناتج عن انحسار مياه الانهار وقلة الأمطار يؤدي إلى تعطيل الممارسات الزراعية وانتاج الغذاء. وسيؤدي التغير المناخي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى انتشار الأمراض من خلال المياه الملوثة.
ويؤدي الفقر إلى منع الفتيات من مواصلة التعليم واستغلالهن للعمل المنزلي أو في الحقول أو الزواج المبكر. طرق المواصلات في جنوب العراق لا تشير إلى أن البلد يحتل موقع رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم. ولا تختلف الأحوال في السماوة عما تراه في الديوانية والنجف، فهي أيضا غارقة في الوحل شتاء، والعواصف الترابية والحر صيفا. إنها مدن تعيش فوق ما تم تأسيسه من بنى تحتية رمادية في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، بنى تحتية لم يبق منها سوى التهالك. وتعتبر العاصمة بغداد من بين المدن الأكثر تضرراً من ناحية البنى التحتية للمياه، ويعاني سكانها من انقطاع مياه الشرب يوميا، ناهيك عن تفشي الأمراض عن طريق المياه الملوثة حيث تتسرب مياه الصرف الصحي إلى شبكات مياه الشرب. الأسماك في خطر. الحيوانات في خطر. الحشرات في خطر. الإنسان في خطر، ومهدد بتفشي السرطان والأمراض والأوبئة لأنه ترك لمصيره الكئيب. هذا وغيره لم يلتفت له أحد من النخبة الحاكمة.
إن معالجة ظواهر بيئية خطرة على حياة أربعين مليون عراقي يستدعي القيام الفوري بالتخطيط، والإحصائيات الدقيقة، والتنفيذ، والحلول الملحة، والبرمجة، والعقلية العلمية المنفتحة على ما يجري في الدول المتطورة. وكل هذا غير موجود في أجندة النخب السياسية والاجتماعية والدينية المتعبة من قنوتها، وتسابيحها، وانشغالاتها الأخروية والمذهبية المفتشة عن طرق مبتكرة للقتل والسرقة والتدليس في الشأن العام.
(*) مدونة نشرها الروائي العراقي شاكر الأنباري في صفحته الفايسبوكية.
المدن