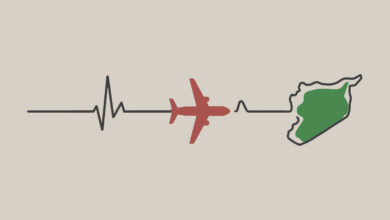قصة بابا عمرو: أول الرصاص في الثورة السورية… في البدء كانت ‘سلمية’

5 – مايو – 2014
’ بابا عمرو ô هيبة الإسم لها وقعها ..، فأهميته لا تكمن في زيارة الأسد للحي بعد إعلان ‘تطهيره من المعارضيين ‘أول مرة، بل لـبابا عمرو قصة طويلة مع الحرب. فبعد إندلاع الإحتجاجات الأولى في منتصف شهر أذار/مارس 2011، شارك أهالي وشباب حمص بالمظاهرات منذ أيامها الأولى بشكل كبير ودوري تضامناً مع باقي المناطق السورية المشتعلة،وكان تجمع المظاهرات في أحياء حمص دائماً يصبّ في ساحة الساعة وسط المدينة حتى يوم الإعتصام الشهير والذي حدثت خلاله’مجزرة شنيعة’ عندما أقبلت قوى الأمن التابعة للنظام السوري على إطلاق النار المباشر على المتظاهرين أثناء تفريقه ليلاً، لتقع حادثة مجزرة الساعة في ‘الثامن عشر من نيسان/ابريل 2011’ والتي حصدت العشرات من أرواح الناشطين المعتصمين و المئات من المعتقلين، لم يستطع بعدها المعارضون والمناهضون العودة للتظاهر في مركز المدينة،
لتأتي فكرة التظاهر ضمن ساحات الأحياء وتتنفذ على الفور في ساحة حي بابا عمرو في ‘الثالث والعشرين من أبريل/نيسان’ بعد أيام قليلة من المجزرة،حيث تجمع مئات من الشبان في الحي مشكلين إحدى أكبر المظاهرات في وقتها آنذاك، وبدؤوا يهتفون بأعلى صوتهم ‘حرية حرية’،’بالروح بالدم نفديك ياحمص، بالروح بالدم نفديك يا درعا’ ليعود الأمن مجدداً ليلاحقهم بسياراته العسكرية وليعتقل عدداً كبيراً من المتظاهرين، محاولاً بذلك إخماد الحراك الثوري السلمي في الحي لكن هجماته المتكررة أصبحت تُؤجج الوضع في الحي وتزيد الوضع سوءاً وترفع من أعداد المحتجين الثائرين، فباتت تشن عدة حملات دهم للحي وتقوم بإعتقال شبانه وإطلا ق النار على الفارين منه ليصبح بذلك ‘حي بابا عمرو’ إسماً يتصدر القنوات الإعلامية العالمية والمحلية.
وعندما كررالنظام السوري محاولات اقتحامه للحي بشكل همجي وشرس، تدخّلت المعارضة المسلحة (كتيبة الفاروق بقيادة الملازم أول المنشق عن الجيش النظامي عبد الرزاق طلاس) في أول أيام عيد الأضحى بتاريخ ‘6/11/2011’ بعد شهر من المظاهرات السلمية، لحماية المدنيين في الحي من النظام، وبالفعل استطاعت كتيبة الفاروق وغيرها صدّ اقتحام الجيش السوري لأشهر، ومنذ ذلك الوقت بدأ النظام يفرض حصاراً قويّاً على الحي من جميع المداخل، وخاصّة من جهة ملعب بابا عمرو، الذي سيطر عليه النظام وجعل منه ثكنة عسكرية لآليّاته و عناصره و قنّاصته التي تقوم باستهداف المدنيين في الحي و خاصّة بعد اتخاذ القنّاصة للأبراج المطلّة على الحي موقعاً استرتيجياً تقوم من خلاله بقنص المدنيين مزاجيّاً.
وكما هو الحال بالنسبة لحاجز السكّة الحديدية من الشرق، و حاجز المؤسسة الإستهلاكية في وسط حي بابا عمرو و الّذي أضحى هدفاً شبه يومي لعناصر المعارضة المسلحة في الحي عند محاولات النظام لاقتحام الحي، و نتيجة لذلك تم سحب حاجز المؤسسة في يوم الخميس ’30/12/2011’،و بذلك أصبح حي بابا عمرو منطقة تابعة للمعارضة المسلحة بالإضافة إلى منطقة التوزيع الإجباري التابع لحيّ الإنشاءات
لكنّ النظام السوري عقد العزم على استعادة الحي، حيث قام بعدّة حملات عسكرية متتابعة، كانت آخرها و أشرسها في شهر شباط/فبراير 2012، حيث قام النظام بمحاصرة الحي من كافة المداخل، وحشد قوّاته على أطراف الحي، و قطع خدمة الإنترنت والكهرباء عنه، و في صباح يوم الإثنين6′ من شباط/فبراير 2012 الساعة 6 صباحاً’ بدأ النظام بقصف الحي بكافّة أنواع الأسلحة من ( قذائف هاون، صواريخ، قذائف المدفعية الثقيلة والدبّابات، رصاص متفجّر، وبعض صواريخ الغراد) بشكل لا يمكن تصديقه لمدّة (28 يوماً) قبل الانسحاب، استطاعت فيها كتائب المعارضة المؤلّفة من ألفي شخص فقط صدّ هجوم القوات النظامية – التي بلغ قوامها في المحاولة الأخيرة سبعة آلاف مقاتل بالإضافة للدبّابات و المدرّعات والطيران…. وخلال الـ(28 يوماً) قتل في الحي عدد كبير من المدنيين العزّل، و أعداد كبيرة من الجرحى التي كانت حالتهم صعبة جداً ـ وخاصّةً الأطفال – بسبب النقص الحاد في الأدوية و المعدّات الطبيّة، مما أدّى إلى استشهاد عدد كبير من الجرحى. خلال الـ 28 يوماً المذكورة آنفاً، وبعدها قامت كتائب المعارضة بإجلاء كافّة المدنيين تقريباً إلا من رفض الخروج من الحي، والّذي واجه مصيراًعسيراً بعد الإقتحام.
و قد واجه أهالي الحي صعوبة كبيرة في النزوح من الحي تحت نيران القصف المتواصل، حيث خرجوا في عتمة الليل و اجتازوا مسافة تقدّر بـ 3 كم مشياً على الأقدام، علماً أن معظم النازحين من الحي هم من الأطفال و النساء و الشيوخ، فيما انشغل رجال الحي وشبابه في صدّ هجوم النظام حيال إخراج أهلهم، وفي يوم السبت 3/3/2012 استطاعت عناصر الحرس الجمهوري و الفرقة الرابعة اقتحام حي بابا عمرو – والذي أضحى ركاماً فوق ركام – من جهة ملعب بابا عمرو بعد انسحاب كتائب المعارضة و إجلائها للمدنيين، قامت بمداهمة كافة البيوت ‘ما تبقّى منها في الحي’ وقامت بالقبض على الأهالي الذين بلغت أعمارهم الخمس عشرة سنة وما فوق إلى المؤسسة الإستهلاكية، حيث تم تعذيبهم بأقسى أنواع الضرب الجسدي وإعدام السبعة عشر شاباً في الحي و التمثيل بجثثهم، وإعدام عشرة شبّان آخرين خلف المؤسسة الإستهلاكية الّتي تحوّلت إلى معتقل كبير،كما قام بعض الشبيحة الطائفيين بإعدام ما تبقّى من العائلات داخل منازلها، ونهب ما خفّ وزنه وغلا ثمنه من (أثاث وثياب ونقود وذهب) وبعدها أحرقت المنازل و منعت الأهالي من دخول الحي وذلك بفرض حظر تجوال على أطرافه عن طريق القناصة المتمركزة على أبراج حي الإنشاءات، ولكن الخطوة الأكبر و الأخطر التي قام بها النظام هي بناء جدار إسمنتي بطول’ 2.5 متر’ في شارع الكرامة (الشارع المؤدّي إلى أطراف حي بابا عمرو) لمنع الناس من الدخول إلى الحي و إجبارهم على المرور من الحواجز (حاجز الفرن الآلي ـ حاجز دوّار الجسر ـ حاجز ملعب بابا عمرو) المعروفة بالطائفية وسوء المعاملة للأشخاص واعتقالهم وأخذهم إلى الأبنية التي قاموا باتخاذها ثكنة عسكرية لهم في حي الإنشاءات وتحويلها إلى مفرزات أمنية صغيرة يتم فيها التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم ومن ثمّ اقتيادهم إلى فرع الأمن السياسي القريب.
يسرد القيادي السابق في صفوف المعارضة المسلحة في بابا عمر أبو محمد المشهداني ‘كتيبة أحرار العشائر ‘لـ’القدس العربي’ قصته وقصة الحي بشكل ملخص وسريع ‘كنت قد خدمت النظام قبل الثورة لسنوات ومن ثم استقلت لحِرماني من تأدية الصلاة وبدأت أعمل بائعاً للخضروات في محلي التجاري الكائن وسط الحي قبل أن أكون قيادياً لإحدى المجموعات المسلحة المناهضة للأسد، فعندما بدأت الثورة تظاهرنا منذ البداية لأشهر حتى أصبحنا نفقد أقاربنا وجيراننا وأحبتنا بين شهيد برصاص الأمن ومعتقل في أفرعها. وفي أواخر ايلول/سبتمبر بدأ معظمنا بالتسلح لأننا أصبحنا نشهد حالات اغتصاب لأعراضنا،عندما كنا نفر من المداهمات تغيرت المعادلة في ذلك اليوم كليّاً عندما علم النظام أنّ شباب الحي ذي الأغلبية العشائرية قد تسلح وسوف يقاومه إن اعتدى في الأيام المقبلة، لم يعد يستطع التحرك تجاه مظاهراتنا، في حينها بدأ مشهد الإشتباكات الشبه يومي وأصوات الرصاص ليلاً في كل مكان، وأصبح الحي يشهد نزوحا للعوائل يومياً إلى حي جورة العرايس المجاور له، أضحى النظام يقيم حواجزمن الإسمنت وجدرانا عالية….. لقد بتنا محاصرين ‘يقولها بحسرة وهو يلقيها علينا ‘(ومن ثمّة يتابع ) القصف الوحشي علينا ولأول مرة وكأننا إسرائيليين على جبهة الجولان والذي يدعي مقاومته لها، كنا لم نعش نحن و أطفالنا حرباً من قبل من هنا بدأ الدافع القتالي يكبر بين شباب الحي،أصبحت المجموعات والكتائب تتشكل،طالبنا بسلاح من الريف وأذكر أننا وصلنا في النهاية إلى ثمانٍ وثلاثين مجموعة مقاتلة أبرزها ‘كتيبة الفاروق’، ذلك لم يجعلنا نفكر أن نعتدي على أي فرع أمن رغم القصف علينا لأنّ مهمتنا كانت تكمن في الحفاظ على المظاهرات السلمية بانتظار حل سياسي محاولات اقتحام عديدة خلال الشهور الأولى من عام 2012 بعد القصف الذي شهدناه لمدة ثمانية وعشرين يوماً محاصرين بشكل مطبق وقصف متواصل بالمدافع والطيران لم تشهده أي منطقة سورية من قبل، لقد كنا في ‘وجه مدفع الثورة ‘ الخيار الأنسب هو الإنسحاب قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة الحي في ‘الـ27 من أذار/مارس 2012’واقفاً على ما ارتكبته قواته من ‘إنجاز’ في تطهير الحي من الإرهابيين كما ادعت وبعد عام كامل أمضاه الحي تحت سيطرة النظام وزيارة الأسد له ومنع سكانه بالعودة إليه،قررت بعض الكتائب التي أنشئت داخله العودة إليه بعد ستة أشهر من التحضير والمرابطة على حدوده في كفر عايا التي تبعد عنه عشرة كيلو مترات جنوبا ً بدأ الزحف والتسلل إليه من عدة أماكن كان أبرزها ‘تل الوعر’ وهو تل يربض طبيعياً خلف الحواجز التي أقامتها قوات النظام،وقاموا في الوقت ذاته بالتفاف نوعي دون مشاهدة الجيش النظامي لهم حيث كان عدد المتسللين أربعمئة مقاتل وبدأ الهجوم المباغت صبيحة العاشر من أذار/مارس 2013على الحواجز المحيطة به ليتفاجأ مقاتلو النظام بحدوث الهجوم من خلفهم وليتركوا جبهاتهم خالية حيث فرّ معظمهم إلى حي الإنشاءات، في حين أرسل النظام طائرات حربية لتنفذ الغارات عليه وبعد أيام من دخول المعارضة إليه انسحبوا منه بسبب قلة إمكاناتهم ليدخل النظام مجدداً إلى الحي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته ولكن هذه المرة لم يبق للحي أي معلم من معالمه.
يقع حي بابا عمرو في الجهة الغربية الجنوبية من حمص ويحدّه من الشمال كلاً من حي الإنشاءات والمحطة ويحاذيه من الشرق حي جورة العرايس وحي الشماس وجامعة البعث ومن الجنوب الإدخار والسكن الشبابي وكفرعايا ومن الغرب تلاصقه بساتينه ومزارعه المقطوعة بأهم السكك الحديدية المارة بحمص.. يفترض بابا عمرو أنه الباب الثامن للمدينة وهو عبارة عن أبنية متتالية للسكن الشعبي في حمص وقريبا ًمن جامعتها ومدخلا ًرئيسيا ًلها.
القدس العربي