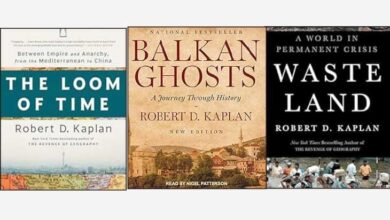“أين اسمي؟”.. من روائية المحو إلى بناء الاختلاف/ ليندا نصار

تبني ديمة الشكر في روايتها “أين اسمي؟” الصادرة عن دار الآداب (2021) منطقة ملتبسة بعدد من الخطابات الثقافية، وهي تتناول مرحلة دقيقة من تاريخ المرأة وذاكرتها المعطوبة كما لو أنّ السرد في رؤيتها هو ترميم لإحساس مؤلم بالمحو. تنطلق عوالم الرواية من شخصيّة أنثويّة تدور حولها الأحداث ويتدحرج معها السرد الروائي عبر حبكة يتداخل فيها التاريخي بالتخييلي من دون السقوط الفج في التأريخ ما دامت الكاتبة تؤكّد مع هذا العمل الروائي قدرتها في الصنعة الروائية، بعدما استطاعت أن تقيم مسافة بينها كناقدة متمكّنة وإبداعيّتها التي تؤشر على نجاحها في طرح أسئلة على الواقع الراهن ولو من بوابة كتابة حكاية داخل تاريخ منسيّ. إنّها تقدّم معرفة للقارئ عبر سرد الأحداث بالأسلوب الفنّي وتتحرّك الشخصيات وفق ارتباطها بالزمان والمكان اللذين لا ينفصلان. إنّ الرواية استدعاء للحظات المنسية وتأريخها وتوثيقها عبر تقنية المزج بين الذاتي والموضوعي لتثير الروائية قضيّة الإنسان في المجتمع بسياقه التاريخي ضمن عملية دمج الفن بالتاريخ من خلق تجربة متخيلة.
في الحاجة إلى هوية للاسم المجروح ذكوريًّا
يثير التفكير في مجهوليّة الاسم، بوصفه سؤالًا مؤرقًا، البحث عن هويّة أنثويّة أو بطاقة تعريف سقطت خلسة من الجميع وسط رفض مصير جاء وفق هيئة سؤال حمله عنوان الرواية، وما هذا الطرح إلا تمثيل لكلّ امرأة أرادت القليل لنفسها ولم تحصل إلّا على الأقلّ منه، بل هي كلّ امرأة ولدت في المجتمع العربيّ ولم تسمح لها الفرصة بالتحليق نحو فضاءات تمنّتها في طفولتها، فكبرت ووجدت نفسها معلّقة بحلم تدلّى من طائرتها الورقيّة الهشّة.
في العنوان إدانة لواقع ما تعمل الرواية على تمثيله بوساطة السرد للكشف عن الخطابات التي تهدّد هذه المرأة ليس في وجودها الماديّ فحسب، بل في حضورها الرمزيّ أيضًا.
إن توظيف العنوان بهذه القوة الإيحائية يفرض على القارئ أن يصبح محقّقًا متحرّيًا عن الحقيقة في نصّ الرواية. إنه سؤال مفتوح على إجابات محتملة ودلالات تتوسع منطلقة من امرأة الزمن الماضي إلى امرأة الزمن الحاضر.
يمكننا هنا استدعاء الذاكرة لنقرأ عن هذه المرأة التي أطلّت من غرفة فرجينيا وولف على الكون، ومن زحمة الوجود التي جعلت كلمات جين أوستن تنطلق إلى العالم بالرغم من فقدان خصوصيّتها وسرقة لحظات الكتابة، كذلك نعود إلى امرأة كافكا القارئة الناسخة المدوّنة، كما نجدها في شخصية أخرى وفي دور آخر تعود بعض صورها إلينا هنا بحيث نراها الشاهدة على جريمة حرب ومذبحة وإذلال ما زال وقع صداها في ذاكرة الأجداد. فكيف يمكن للمرأة أن تحتفظ بذاكرة مليئة بتفاصيل عمر مضى؟ هي قمّور الشابّة التي تحاول الانطلاق في حالة من الوعي واستفزاز ذاكرتها وسيرتها الذاتية لتوثّق الذاكرة الجماعيّة.
المرأة أو ظفيرة السرد الهويّاتي والرغبة في التطابق
المرأة التي لطالما عاشت حالات الهشاشة الكامنة في رفضها بوصفها ذاتًا داخل أنماط التفكير في المجتمع وتمّ تحديد دورها بتسوية معيّنة مع الرجل، أبت أن تظلّ خاضعة للوضع نفسه وانطلقت تقاوم هذه الصورة الكاتمة على روحها عبر وسيط الكتابة بوصفها شكلًا من أشكال مقاومة الهيمنة والتسلّط باحثة من خلال العمليّة الكتابيّة عن هويّة تطابق أحلامها المؤجّلة ورغباتها المستمرّة في التحرّر كي تضيء مناطق الاختلال المظلمة لتخرج من عالم الظلّ فتشعّ في نور عالم الكتابة بالرغم من كلّ ما واجهها من محو لهويتها. فما كان لها إلا اسم مكتوب بخطّ صغير إلى جانب اسم زوجها “حنّا” حيث تتجلى النزعة الذكورية التي تهمش ليس اسمها فحسب، وإنما وجودها الأنطلوجي.
تشتغل الكاتبة على بناء الذاكرة المحطّمة التي تستحق الإنعاش والعودة إلى الحياة من خلال الكتابة. أليست وظيفة الكتابة لدى رولان بارت هي تشييد فضاء مشترك تلتقي فيه اللغة والإيديولوجيات بالذات والتاريخ الموضوعي؟ فكيف كتبت ديمة الشكر تاريخ الذات الأنثويّة العربية في رواية “أين اسمي”؟
تعرض الشكر ملامح وتفاصيل حياة “قمور” الشابة وتعتني بها وتجعل قارئها يقيم في المسافة الفاصلة بين الحياة المتخيّلة التي تتمناها كل فتاة، والواقع المرير الذي تسبّبه الحروب والمذابح التي تأخذ أجزاء من أعمارنا، وتتّخذ هذه الحياة فلسفة تتراوح بين الجسد المعطوب والعقل المختلّ بفعل الرغبة في النسيان وكتابة ذاكرة الماضي للعيش في الحاضر والتأسيس للمستقبل بهدف ترميم تلك الهوة التي تعلي من مساحات الانسلاخ وتدمير الذاكرة وهوياتها؛ حيث تسعى الشكر إلى شحن الأماكن برؤى مختلفة تسير من الذاكرة الماضية بتفاصيلها لتستقر في الواقع وتحاول بالكتابة استعادة حقّ المرأة ونقصها وتعرض تجربة المرأة في مجتمع ذكوري متسلّط بأسلحة المحو؛ فعدم اكتمال الهوية هو دليل نقص في حيوات المرأة المُهَدَّدَةِ والمُهَدِّدَةِ لوجودها في ظل سطوة الخوف وكأنّ قمور لا سلاح لها سوى القناعة بهذا النمط من الحياة، التي بالنسبة إليها، لا تستحق كلّ هذا النضال من أجل هويّة لترضخ للقنصل ريتشارد وتعيش مع نفسها تجربة الكتابة هاربة من قصتها الحقيقة وسيرتها الذاتية التي كانت مجبرة على كتابتها وتوثيقها لينجح العمل الكتابي وليعتبر انتصارًا لها. وهنا السؤال أوليست الكتابة شجاعة تقاوم أغلال الهيمنة؟
روائية التاريخي وسردية الذاكرة
إذًا تدور أحداث هذه الرواية في القرن التاسع عشر مستعيدة حدثًا تاريخيًّا يؤرّخ لمذبحة باب توما عام 1860 التي شردت وقتلت الأطفال والنساء ونقلت حياة العائلات إلى ضفاف غير متوقّعة وقد كانت الأساس في العمل الروائيّ؛ فقمّور هي حكاية الرواية منذ البداية وحتى نهايتها؛ هذه الفتاة الشابة التي كانت تعمل خادمةً في منزل السيد ريتشارد بيرتون وزوجته إيزابيل، وهو مُترجم ألف ليلة وليلة إلى الإنكليزيّة، وتأتّى لها بحكم عملها داخل أسرة السيد ريتشارد اكتشاف جغرافيات قادتها نحو السفر والإقامة في لندن وتريسته ما جعلها تترجم صوتها الخاص عبر الكتابة رافضة أن تكون رواية سيدها ريتشارد هي الرواية الوحيدة عن مذبحة باب توما في دمشق (1860) وذلك انطلاقًا من موقعه وتصوّره لها. غير أن في كتابها عن المذبحة التاريخيّة، صودر اسمها ما دامت كاتبته امرأة وكأنّ الرقابة تصبح مضاعفة حين تعمل بكل الأشكال على تجريد المرأة من حقّ وضع اسمها على مُؤَلَّفِها. تطرح الرواية إذًا، في سياق مجهولية الهوية، إشكالًا لا يتّصل بشخصية قمور التي تتوحد مع معالم مدينتها إلى درجة التطابق؛ فحالها لا يختلف عمّا شاب تصوير المدن العربية في متخيّل الآخر الطافح بكل أشكال “البربرية” حين عمد الاستشراق إلى تخييل أناسها بوصفهم كائنات لا علاقة لها بالحضارة أو الإنسانيّة ما دام حلمه هو نفي الوجود عن كل ما يقوّض هويّة هذه المدن وتراثها.
إن تمثيل الرواية لأنثوية مسحوقة مسلوبة على مستوى التصوير، كما تؤكد ديمة الشكر، ما هو إلا صورة كل امرأة بل كل مدينة خضعت للسيطرة بسبب الحكم المسبق عليها كمخلوق ضعيف؛ ذلك أنّ حالات الرفض المبطّن سترافق قمور الشابة في مسيرها وبحثها عن هويتها الخرساء بفعل عمليات المحو المتكررة على جميع الأصعدة في أحداث الرواية؛ فالشكر ترصد في روايتها مظاهر الحياة بتفاصيلها عبر أحداث مألوفة تعيد ترتيب المذبحة وتبني تأويلها عبر التخييل الروائي كاشفة لتفكيك خطابات تربك القارئ بدقّتها على مستوى المكوّنات الاجتماعية والصراع الطبقيّ الذي يقبع تحته المجتمع مستغورة طبائع ونفسيات شخصياتها في علاقتها بالمستعمر وسعيه الدائم لتأكيد هويته وتقويض الذاكرة الجماعية. فما الفرق إذًا، بين مذبحة باب توما والمذابح والجرائم العالمية التي تقترف اليوم بحق شعب بأكمله، بل بحق وطن؟ مع ديمة الشكر في هذه الرواية، تصبح الشخصيات الهامشية الخرساء والتي لا تتكلم إلا نادرًا، مرمّمة لفراغ المرويات في التاريخ الرسمي من أجل وجود عناصر الحكاية واكتمالها.
لم تقم الكاتبة بعرض التحوّلات فقط، بل عملت على معالجتها وفق بناء سرديّ تعاقبي خلقت بموجبه حبكة داخل فضاء الرواية لتقدّم رؤيتها لما يمكن أن يقع “في التاسع من تموز 1860…” وكل الأحداث القاسية التي تلوّنت بالدماء آنذاك؛ حيث نجحت هذه الرواية في بناء عالم يتضمّن شخصيات ورموزًا لها وجودها الواقعي، ما يعزّز قدرة الكاتبة على تشييد منطقة الاحتمالات بين ما يحكى وما لم يُحكَ إلّا في رواية البحث عن مجهولية الهوية. تكتب قمور إذًا، الرسائل قسريًّا بأمر من القنصل ريتشارد محاولًا إلغاء دورها وتشكيل شخصية الفتاة بديكتاتورية تخضع لها؛ فهي تجبر على التذكّر حتى تستطيع أن تمشي مع ذاكرتها جنبًا إلى جنب وتكشف عن حقيقة موت والدتها ولتكون جزءًا من سيرتها سيرة الطفولة المسلوبة عن طريق تصوير حالات الخوف بدقّة متناهية وما يطبعها من قلق تعيشها الشخصيات في تلك الفترة حيث المذبحة ما هي إلا تمثيل لكل المذابح التي يشهدها كل طفل عاش الحرب والتشرد الذي تسببه.
إنّ قارئ “أين اسمي؟” يجد نفسه أمام تحولات عمرية سريعة تبدأ من الطفولة فمرحلة الشباب التي تستعيدها ذاكرة قمور وتقف عندها محطّات تأمّلية وفق رؤية جماليّة تبني بوساطتها هويّة المدينة، هويتها المجهضة، لتمنح قارئها عبر تقنية التصوير بالتناوب، إمكانات لتأويل علاقة الكتابة بالسلطة والرقابة ووضعيات امرأة شاهدة في لحظات قاسية تؤمر فيها بالكتابة ومن دون أن تكون فاعلة وسط عبارات حاطة من كرامتها توجه إليها وكأنها طلقات رصاص أمام مقصلة الموت وعلى مرأى من الجميع وهي معصوبة العينين وعارية. إنها كتابة المرأة التي، على الرغم من صوتها الداخلي المجهض، إلا أنّ حالاتها تأخذ أشكالًا لفهم الاستبداد على نحو جمالّي من خلال تفكير الأدب في كل أنماط القهر والسادية.
في نهاية الرواية تأخذنا ديمة الشكر بكلّ خفّة وبطريقة لامتوقّعة عبر الزمان، فينتقل القارئ من القرن التاسع عشر إلى القرن الواحد والعشرين، إذ تعمل ببراعتها على خلق شخصيّة جديدة أرادتها أن تصنع نهاية روايتها، إنّها زينة المرأة التي تجتمع بقمّور في زمن آخر وتحاول الانتصار لها ولاسمها الذي وضع بخطّ صغير خلف اسم زوجها، وكأنّ القدر أراد لقمّور المقهورة والمسلوبة أن تحصل على حقّها ولو بعد حين.
عنوان الكتاب: أين اسمي؟ المؤلف: ديمة الشكر
ضفة ثالثة