الدولة الحيادية، لماذا تكون خيارنا الأقرب!/ شيماء البوطي
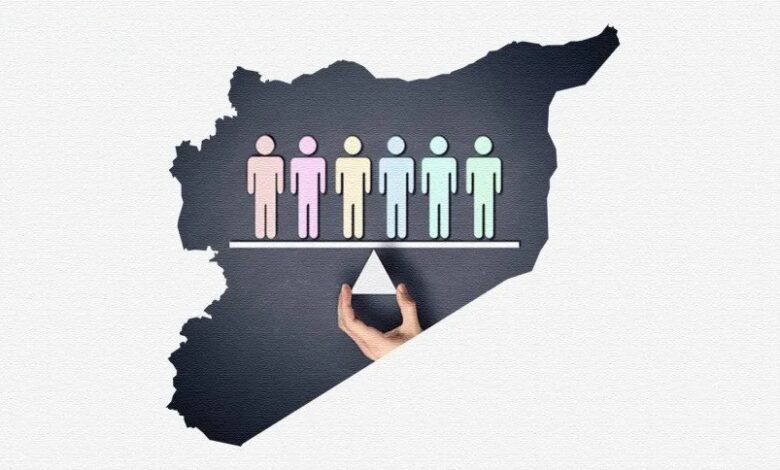
نشر في 1 أيار/مايو ,2025
تنويه:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
يظهر مصطلح حيادية الدولة كمصطلح أكثر لطفًا ومقبولية وأقل صدامية في صراع المفاهيم الذي دام أكثر من قرن بين ثنائية (إسلامية/ علمانية)، وظل مسببًا للاصطفاف الأيديولوجي، ومحرّضًا على خلاف يدور في دوامة لا تنتهي بين أفكار عدة: “الدين سبب التخلف”، “العلمانية هي الحلّ”، “الإسلام هو الحل”، “لا بديل عن الديمقراطية”. وعلى الرغم من أن الدولة الحيادية هي نفسها الدولة الديمقراطية العلمانية، فإن المصطلح نأى بالمعنى عن صور العلمانية المتطرفة المعادية للدين التي لا تقف على مسافة واحدة والتي تجعل المصطلح مثيرًا للجدل، فتحمل الدولة الحيادية في طيات المصطلح التدرج بنشر الديمقراطية في المجتمع حتى تتأصل حيادية الدولة، كذلك ينأى المصطلح عن حساسية علاقة الدين بالسياسة، لأنه يعبّر عن انفصال واستقلال الدولة عن جميع أشكال البنى التقليدية ما دون المجتمعية، من الدين إلى القومية والمناطقية والطبقية والذكورية والسلطوية والطائفية، وغير التقليدية كالأحزاب وغيرها.
فالدولة الحيادية بوصفها تقوم على احترام الحريات والتكافؤ، فلا تمثل مجموعة على حساب أخرى ولا يتم توزيع المناصب السيادية والإدارية بناءً على انتماءات أو محاصصات من دون أن يمنع ذلك دعمها الجماعات الدينية المعتدلة بدعوتهم لأفكارهم، وتحمي حرية ممارستهم الشعائر، في الوقت الذي تتصدى فيه لاستخدام الدين لتحقيق أهداف أفراد أو جماعات سياسية، وتضع القانون في مسؤوليته لحماية الإنسان وحفظ حريته وكرامته، لا للتدخل في شؤون في حياته، وتضبط العمل السياسي للمؤسسات الدينية والأحزاب من دون أن تصادر حقهم في المشاركة السياسية. مما يجعلها تشكل ضامنًا لتحقيق المساواة بين المواطنين، وسببًا لاستثمار التنوع والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد، ومانعًا لتغوّل فئة على فئة أو جنس أو عرق على آخر، وسبيلًا أجدى لتحقيق تكافؤ الفرص وإخماد النزعات الفردية تدريجيًا حتى تتلاشى، ويصبح الجميع على صعيد واحد، كأسنان المشط لا تفاضل بينهم إلا بمقدار ما يقدمون للوطن والشعب.
وهي أيضًا ضامن لترسيخ انتماء المواطنين جميعًا، وبلورة هوية جامعة وتفعيل مساهمات الجميع، أقلية وأكثرية، من دون أن يشعر البعض أنه ضيف في وطنه على فئة أكثر عددًا، مما يعزز بناء الثقة بين أبناء المجتمع دون أن يكون السلم الأهلي منحة من الأكثرية للأقلية. ومن ثم ينتقل المجتمع إلى سياق الدولة الحديثة القابلة للنماء والازدهار وتحقيق الرخاء للجميع. هذه الصورة تبدو كحلم جميل يتطلّع إليه الجميع، إذا تغاضوا عن الصراع الأيديولوجي العلماني/ الإسلامي، وتبدو أقرب مسعى لتحقيق الحكم الرشيد والسلام المجتمعي. ولكن قد يقول قائل؛ الدولة الديمقراطية تنبذ الشريعة الإلهية، وتتبنى شرعة وضعية وضعها أناس من خارج مجتمعنا، لهم تجربتهم وخصوصيتهم، فلماذا نتبنى قيمهم، ولدينا قيم خالدة ودين ليس كهنوتيًا بل هو للروح والحياة معًا، ينظّم حياة الفرد وعلاقته بربه ومجتمعه وعلاقته مع الآخر ومع الكون عمومًا؟
وقد يقول قائل: أليست الدولة الديمقراطية المنشودة صورةً من الدولة الإسلامية التي لم تكن يومًا عبر التاريخ من نوع الثيوقراط، باستثناء ظواهر عابرة غير منتمية للحكم الإسلامي الذي تتفق عليه غالبية الأمة، شأن الدولة الفاطمية على سبيل المثال؟ أليست قيم الإسلام السياسية تقوم على العدل والرحمة والمساواة والشورى؟ فلماذا نذوب في الآخر ولدينا هذا التراث وهذه المنظومة القيمية؟ ولماذا ندخل في دوامات قد تتعارض مع الدين أو تقوض الأسرة كقضية تولي المرأة أو سفرها بغير محرم أو الزواج بأمر الولي أو المواريث؟
وهنا، لا أجد نُدحةً في التعريج على بعض هذه القضايا التي يُنظَر إليها كمتعارضة مع حقوق الإنسان، والمشكلة أن كثيرًا من هذه الأحكام لم تُقرأ بشكل صحيح أو تم دمج المقدس بغير المقدس، فمنها ما لا يستند إلى نص، بل هو مجرد عادة اجتماعية بالية كزواج القاصرات، ومنها ما ارتبط بظرف في عصره كان يجب أن يُفهم أنه للاحتراز وليس للانتقاص -لولا الفقه الذكوري- كسفَر المرأة وحدها، فإذا اختفى الخطر وتغير الظرف يتغير الحكم، ومنها ما يتناقض مع نص قرآني، كالنص الذي يثني على حكم بلقيس الرشيد ثم يأتي من يحتج بحديث آحاد على تحريم تولية المرأة، وليس لذلك ذكر في صريح المحرمات، ومنها ما استقي من التاريخ، وليس من جوهر الدين ولا مما فيه نص، كحكم الردة الذي يتعارض مع حرية الاعتقاد ومع نصوص واضحة مناقضة له تؤكد سموّ مقصد حرية الإنسان واختياره الهدى أو الضلال بلا إكراه، ومنها ما انتفت المساواة المادية فيه لصالح الرجل، بمقابل زيادة الأعباء عليه والتكاليف والإنفاق كمسألة المواريث، وبعض هذه الإشكاليات لا يشكّل أمرًا عند غالبية المسلمين إلا من تعرّض لظلم مباشر، وحل هذه المسائل يأتي بالقانون والاحتكام لقرار الشعب (الشورى)، مع تفصيل اللوائح التنفيذية لأي قانون بحيث تمنع الظلم والشعور بالانتقاص من أي مواطن، فغاية الدين حماية الإنسان وتنظيم حياته، لا قهره وقمعه. وكل هذا يحتاج إلى مراجعات وإعادة نظر وقراءة جديدة للتاريخ وللموروث الديني، بعيون متفحصة وعقول متحررة من ربق التقليد الأعمى والتقديس للرموز التاريخية.
وللإجابة عن التساؤلات السابقة، نرى أن القيم القرآنية في السياسة لم تشكّل سوى خطوط عامة عريضة دون تفاصيل، والممارسة السياسية الإسلامية لم تأت جميع تفاصيلها من نصّ أو من تطبيق النبي لها، بل من العهود اللاحقة حين اختلط المسلمون بغير المسلمين، وبالممالك والإمبراطوريات القائمة في ذلك العهد، وأفادوا من نظمهم السياسية والإدارية وفق منظور العصر الذي كانوا فيه، أما عن القيم السياسية العامة، فهي قيم خالدة يتفق عليها بنو الإنسان، وليست خاصة بأمة دون الأمم، كالعدل والمساواة والحرية والشورى التي جاءت بلفظها وشكّلت منطلقات العمل السياسي الإسلامي، وإن غفل البعض عن قيم أخرى أدرجت في النصوص نحو “يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالحق” و”خذ العفو وأْمر بالعرف”، فهل العُرف هو عرف القبيلة في أحكام الذكورة والثأر وجرائم الشرف؟ّ! أم هو ما يتعارف عليه المجتمع في عصر أو بيئة زمانية أو مكانية، بما يتسق مع الفطرة الإنسانية السليمة والنقية، وهذه تتفق مع معظم ما جاء في الشريعة الدولية لحقوق الإنسان؟
مشكلة الإسلاميين أنهم يعيشون ضياعًا بين عدة مفاهيم، فيلجؤون حينًا إلى الترقيع والانتقائية، ويلبسون هواهم في الانتماء والعيش في التاريخ الجميل لبوسًا معاصرًا، متغافلين عن حل ثغرات لا تتسق مع النموذج الذي يطرحونه، وهم يتبنون فكرة أن الديمقراطية هي عينها الإسلام، أو هي الوحش الكامن المتأهب للانقضاض عليه على حين غرة، فيأتي ثوب الدولة الإسلامية الديمقراطية متداخلَ الألوان بين مفاهيم ومصطلحات تشتتت بين النص والتطبيق، بين دين مقدس وتاريخ أو ممارسات غير مقدسة، وتنزيل الأحكام بغير ما أتت فيه أو فهمت وفقه في عصر أو سياق ما. وبعض صور هذا التيه هي في خلط قوانين المجتمع بأحكام السياسة وخلط التشريع بالعادات.
ولا نقول إن الأمرين لا يتلازمان، أي المجتمع والسياسة، فديمقراطية الدولة لا تتحقق إلا بديمقراطية المجتمع، وهذا يحتاج إلى رحلة جادة من العمل والتوعية والاتزان في العلاقات ومراقبة القوانين والممارسات حتى تنضج المساواة في المجتمع بين الطبقات والذكر والأنثى والذات والآخر المختلف ضمن الهوية الجامعة والذات والآخر الخارجي، وحتى تلغى الذكورية والاستبداد من نفوس الناس، فلا يتسلط أحد على أحد، ولا يستعلي أحد على أحد، ولا تكون مسؤولية طرف ما أو قوامته أو إدارته لمؤسسة بابًا للتغول والطغيان والوصائية المتنافية مع حقوق الإنسان، بل لتنظيم العلاقة وحماية المرؤوسين وزيادة الإنتاج.
من عجيب أمر الصراع حول الدولة الإسلامية والعلمانية، أنّ المسلمين خارج المنطقة العربية يميلون للمطالبة بعلمانية الدولة، ويجدون فيها ضمانًا لمساواتهم وحمايتهم، باستثناء الدول المتطرفة في علمانيتها، حسب أحد الباحثين، بينما تغرق النخبة العربية في نقاش مسألة دين الدولة ودين رئيس الدولة وتسمية الدولة، وهي أمور مهمة لا ينبغي تجاوزها، إلا أن الدولة مجموعة مؤسسات ونظام، ولها مسؤوليات ومهام تخضع لقانون، وهي تملك سلطة تنفيذ القانون، فأيّ دين يُطلَب من مؤسسة؟!
إنّ دين رئيس الدولة أمرٌ يتوافق عليه الشعب، وأحسب أن الأغلبية ستؤثر في القرار والاختيار، لأن المواطنة لم تنضج بعد بما يكفي، وإن كنت أرى أن التركيز على صفات الحاكم وأدواره ومسؤولياته وما يطلب منه من مهام ومن حماية، وإقراره بسلطة القانون ومحاسبة الشعب، أهمّ بكثير، وتأتي المعضلة في مصادر التشريع، ذلك أن إنكارها يدخل في دوامة، وأخذها -كما يعرفها الإسلاميون- يدخل في دوامة أخرى، فهنالك بين فهم النص وأخذه بحرفيته، وفهمه في سياقه وفهم إطلاقه وتعميمه، اتسعت أبواب من الشرح والفقه والتحليل، لا أنكرها ولكنني أدعو لإعادة النظر بها، لأجل صوغ قوانين تستند إلى المقاصد الشرعية وتراعي فهم الواقع الراهن.
كمسلِمة، أوقن أن الدين الإسلامي من مصدر إلهي؛ وهذا لا يلزم من لا يؤمن أن يرى ما أراه، لكنني أرى الدين من عند الخالق الذي لا يتعصّب لقوم من خلقه على آخرين، فالخلق كلّهم عيال الله، وإن كان قد اختص أمة من الأمم بمنهج يصلح للحياة والعبادة يضعهم على طريق المسؤولية لنشر أفضل السبل، لا ليكونوا شعب الله المختار، الدين الذي من عند الله هو دين كرَّم الإنسان، ووهبه العقل والقدرة لينتج ويجتهد ويطوّر، لا ليكون حارسًا على نتاج من قبله ولا ليكون مقلّدًا، ولقد ظلّ النظام السياسي في الإسلام غائمًا وغير مفصل، مقارنة مع أحكام العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات والسلم والحرب، ومن هنا جاء اللبس، وتدخُّل البشر في شرح بعض النصوص، وجعلها تستخدم أحيانًا كوسيلة سياسية لتثبيت حكم الفرد وتبرير استبداده. وهذا أمر يجب أن يرفضه المسلمون قبل غيرهم، فالنصوص الشرعية اكتفت بذكر المبادئ العريضة، وتركت اختيار الأنماط والتسميات والتقسيمات والتفصيلات وشكل الحكم وهياكله لاختيار الإنسان بما يلائم عصره وظرفه.
أخيرًا نقول: إن الديمقراطية نفسها ليست مثالية ولا مكتملة، ولكنها تقدّم نموذجًا شبه متكامل للنظام السياسي، يتلاءم مع مقتضيات الحياة بأكبر قدر من التوافق مع قيم مجتمعنا وثقافته، أنتجه العقل البشري بعد تجارب مديدة ونجاح وفشل حتى وصل إلى هذه الصورة، لنفيد منه، ولنأخذ النافع ونطور ما فيه نقص، ونحفظ القيم الخالدة وننبذ الفاسدة، وهي توفّر أرضية للعمل تسمح بالتغيير، وتنزع صفة القداسة عن النظام السياسي، لأنّه لو أخذ صفة البعد الديني لأصبح ثابتًا لا يقبل التغيير، الذي هو سنّة من سنن الحياة.
تحميل الموضوع
مركز حرمون




