مقاربة حيادية الدولة عن الدين.. من الأيديولوجية إلى السيسيولوجية/ عباس شريفة
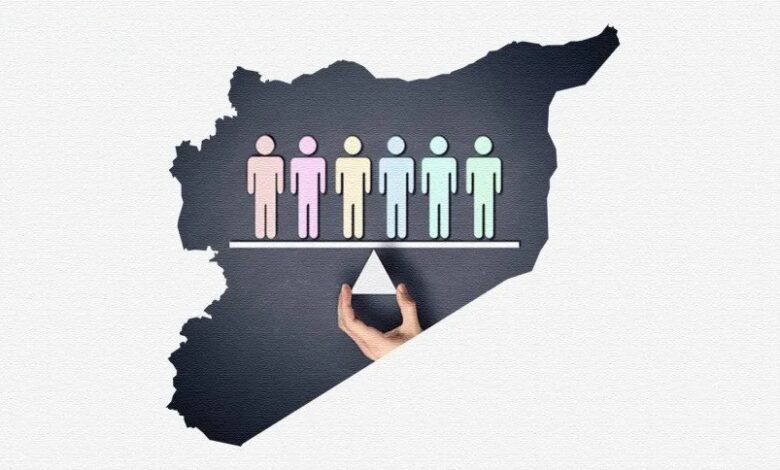
نشر في 5 أيار/مايو ,2025
تمهيد
يُعدّ مبحث العلاقة بين الدين والدولة في المضامين الدستورية من أعقد مباحث الاجتماع السياسي، ومن أكثرها حساسية، في سياق الحوارات الفكرية بين ثنائية الإسلاميين والعلمانيين، حيث تتنوع المواقف بين من يراها علاقة ارتباط مطلق، ومن يراها علاقة انفصال وحياد مطلق. وما أفترضه في تناول هذا الموضوع أن جوهر الإشكال البحث هو البردايم والمنظور الذي نستخدمه في تشريح هذه العلاقة المعقدة؛ فالبردايم الأيديولوجي لأي تيار سياسي سينتهي بالضرورة إلى مُخرجات معروفة مسابقًا، تعبّر عن اصطفاف سياسي سابق على العملية البحثية، ولا يختلف الأمر، سواء أكان البردايم إسلاميًا أم يساريًا أو ليبراليًا، باعتبار أن لكلّ فريق قبلياته النظرية والفلسفية التي يحكم من خلالها على الأشياء. ومن ثم، لا يمكن الوصول إلى نتائج مغايرة ومعقولة وعملياتية، في مقاربة المضامين الدستورية التي تتحدث عن علاقة الدين بالدولة ومفردات العقد الاجتماعي، بدون تغيير المنهج المعرفي والمنظور الإبستيمي في معالجة السؤال البحثي هنا، وهو “حيادية الدولة عن الدين”. ومن هنا، أعتقد أن الاستعاضة بالمنظور السيسيولوجي عن المنظور الأيديولوجي في هذا المدماك مهمّ للغاية، للوصول إلى نتائج مختلفة وأكثر واقعية وأكثر ملاءمة للخصوصية السورية والظرف التاريخي الذي تمرّ به البلاد. وبناءً على ذلك، أفترض أن النتيجة التي سنصل إليها أن حياد الدولة لا يرفع كلّه بالنفي، ولا يقع كله بالإثبات، لكنه يدور في حدود النسبية كنتيجة تتمخض عن علاقة معقدة، بين المجتمع والسلطة والثقافة والوعي. وفي هذا المقال، سنناقش عدة نقاط أساسية في الموضوع.
أولًا: علاقة الدين بالدولة: تفكيك المفاهيم وتحديد الإشكاليات
يُعدّ سؤال “ما علاقة الدين بالدولة؟” من أكثر الأسئلة إشكالية وتعقيدًا، إذ ينطوي على ثلاثة مفاهيم مركّبة: الدين، والدولة، وطبيعة العلاقة بينهما، ما يستدعي تفكيكًا دقيقًا للمصطلحات، والتمييز بين الدلالات المختلفة لتفادي الخلط المنهجي.
1) مفهوم الدين
يقع كثيرون في مأزق الخلط المنهجي بين “الدين”، كمفهوم عام وبسيط يرتكز أساسًا على الضمير الخاص للفرد، وبين “الإسلام” كدين يتضمّن منظومة قيم وتشريعات يتصل بعضها بالفضاء العام وتؤسس لعلاقة عضوية بين العقيدة كتصور فلسفي عن الوجود وبين المجتمع، والمصالح العامة، والأخلاق، والفقه. ومن ثم، لا يمكن إنكار وجود بعدٍ دنيوي في الإسلام، حتى مع الاختلاف حول مدى اتساع هذا البعد من انكماش حدوده.
وهنا، ينبغي لنا أن نعلم متى نفصل بين تراكيب الدين ومكونات الدولة، ومتى نوصل بينهما، فكما أن الدولة مفهوم مركب من حيز مكاني، وسلطة، وشعب، ومؤسسات، كذلك الدين، فهناك دين النص، وهناك دين المعبّر عن النص بالفهم والاجتهاد، وهناك التدين الاجتماعي في بعده الثقافي، وهو ما يظهر في سلوك الناس. ولذلك لا بد من مقاربة دقيقة في صياغة علاقة الدولة مع الدين، تتجاوز ثنائية الفصل والوصل والحياد السلبي والحياد الإيجابي، إلى مقاربة جديدة تُوائم بين حقوق الإنسان والديمقراطية ودور الدين في الفضاء العام، باعتباره أحد مكونات الثقافة للشعب حتى في تحديد ما هو الفضاء العام أصلًا، خصوصًا أن بعض استطلاعات الرأي تؤكد رغبة الشعب السوري في وجود نوع من العلاقة للدين[1].
2) مفهوم الدولة
تتشكل الدولة من الركن الجغرافي، وهو الأرض والحيز المكاني الذي تقوم عليه الدولة؛ ومن الركن التنظيمي وهو المؤسسات الأساسية من قضاء وحكومة وبرلمان؛ ومن الركن السياسي وهو السلطة التي تحتكر القوة وتنفيذ القانون من خلال تشريعها وتنفيذها والمقاضاة عليها؛ ومن الركن الإنساني وهو الشعب. وبين الشعب والسلطة مكونات وسيطة هي المجتمع المدني والأهلي، وهنا بلا شك لا يمكن اعتبار الدولة في ركنها الجغرافي ولا في ركنها التنظيمي منسوبة للدين، لكن الشعب -بلا شك- يحمل دينًا وثقافة، ومن ثم فإن عملية فصل الدولة بالمطلق وتحييدها تمامًا عن الدين تعني تحييدها عن الشعب، وهو أمر متعذر خصوصًا في تشكل القيم الأخلاقية للمجتمع حتى لو كانت القاعدة الأخلاقية لا تشكل قاعدة قانونية، لكنها تشكل الإطار الفلسفي للقانون ومرجعيته. وهنا يبرز دور علم الاجتماع السياسي في دراسة مدى تجذر الدين في المجتمع وتمظهره في السلوك الشخصي وصياغة دوره في صناعة الاستقرار والعيش المشترك، واستصحاب النتيجة لتحديد نوع المضامين الدستورية المناسبة في صوغ هذه العلاقة بين المجتمع والدولة والدين.
3) الحياد باعتباره وصفًا متخيلًا
الحياد الكامل للدولة مفهوم نظري غير متحقق في التجربة السياسية المعاصرة، حتى في النظم الديمقراطية، فالدولة مؤسسات صماء، ومن يدير هذه المؤسسات هو السلطة، والسلطة كيان بشري، والبشر متحيزون بطبيعتهم لمعتقداتهم ومبادئهم، وحتى عندما تُلزم السلطة التنفيذية والقضائية بالتزام القانون لتأطرها على الحياد، لا نستطيع تأطير السلطة التشريعية من التحيز إلى ما تريده الشرائح الاجتماعية التي يمثلونها في صياغة التشريعات. ولذلك تمت الاستعاضة عن الحياد في المؤسسات الإعلامية والبحثية، واستبدال “الحياد” بـ “الموضوعية والمهنية” كمعيار عملي. حتى إن كثيرًا من المفكرين السياسيين ينفي الحيادية حتى عن الدولة المدنية، لأنها تعطي لنفسها حق صياغة الأخلاق العامة[2]. وبناء على ذلك، فإن مفهوم الحياد باعتباره متخيلًا غير متحقق في واقع الممارسة السياسية إلا ضمن حدود نسبية.
ثالثًا: العلاقة بين الدين والدولة ليست بسيطة
ينقسم الرأي في هذه المسألة إلى اتجاهين، هما على طرفي نقيض: الأول ينفي العلاقة على وجه الانفصال التام، واعتبار أن كل ما هو اجتماعي هو شأن عام لا ينبغي للدين التدخل به وحصر الدين في الضمير الشخصي للفرد. والتيار الثاني يثبتها بإطلاق، معتبرًا أن كل تفاصيل الدولة منصوص عليها دينيًا. وكلا الموقفين غير دقيق.
ولأجل فهم أدق للعلاقة بين الدين والدولة، يجب التمييز بين المفاهيم المتداخلة (الدولة، السلطة، الحكومة، النظام السياسي، والمجتمع..)، كما ينبغي تفكيك السؤال المركزي إلى أسئلته الفرعية، مثل: ما علاقة الدين بالسياسة؟ وهل السياسة في الإسلام هي نظرية منصوص عليها أم هي منظور قائم على المصلحة المرسلة التي لم يأت النص لا لاعتبارها ولا لإلغائها، وإنما تركها لتقدير للبشر يقدرونها بحسب مصالحهم؟ ما علاقة الدين بالسلطة؟ وهل السلطة فيه معينة بالنص، كما هو الحال في الفقه الشيعي، أم أن إسناد السلطة متروكة لاجتهاد البشر واختيارهم؟ وهل هناك طبقة klerikos””، وهو رجل الكنيسة الذي يحكم بالحق الإلهي وفق النظام الثيوقراطي، أم أن مسألة السلطة هي قضية مدنية في الإسلام وليست من ترتيب النص الديني أو رجال الدين؟
وهل في الإسلام نظام سياسي مؤسسي أم منظومة قيم فقط؟ والواقع أن الإسلام لم يأتِ بنموذج تفصيلي لمؤسسات الدولة الحديثة وشكل النظام السياسي أهو جمهوري أم ملكي أم دستوري، وترك ذلك لاجتهاد البشر في تحقيق مصالحهم، لكنه قدّم منظومة من القيم السياسية -كالعدل، والشورى، والأمانة والمحاسبة والمسؤولية- تُرشد إلى بناء نظام سياسي، يتوافق مع القيم الإسلامية من دون أن يُقيّده بنموذج تاريخي أو شكل مسبق، ما دامت القيم الأساسية متحققة، وهو عين ما ردّ به ابن عقيل الحنبلي على أحد فقهاء الشافعية، عندما قال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، إذ قال ابن عقيل: “السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك: “إلا ما وافق الشر ع”، أي ما لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح. وإن أردت أن لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط، وتغليط للصحابة[3].
ثم ما علاقة الدين بالقانون، والثقافة، والمجتمع؟ وهل الإسلام دين طقوسي محض، أم يحمل منظومة قانونية وثقافية واجتماعية شاملة، وإن كانت هذه الثقافة مترسخة في المجتمع خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية، فهل نجبر المجتمع على تبني منظومة القانون المدني أم نترك حرية اختيار ما يراه مناسبًا في قضايا الأحوال الشخصية؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تُفضي إلى ضرورة الاعتراف بوجود علاقة بين الإسلام والدولة، لكنها ليست علاقة اندماج تام ولا انفصال مطلق.
رابعًا: هل الديمقراطية من مستلزمات حياد الدولة عن الدين؟
تُظهر المؤشرات الدولية المعنية بقياس مدى التزام الدول بالقيم الديمقراطية أن حياد الدولة تجاه الدين ليس شرطًا جوهريًا لتحقيق الديمقراطية؛ فمؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية، وهو يُعدّ من أكثر المؤشرات مصداقية، صنّف في عام 2020[4] كلًا من النرويج وآيسلندا والسويد ضمن أكثر الدول ديمقراطية في العالم، على الرغم من أن اثنتين من هذه الدول تنص دساتيرها صراحةً على المسيحية اللوثرية كديانة رسمية، في حين تمنح الدولة الثالثة الكنيسة اللوثرية وضعًا دستوريًا خاصًا.
في المقابل، جاء ترتيب دول ككوريا الشمالية وجمهورية الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى في أدنى مراتب الديمقراطية، رغم أن دساتيرها تؤكد الطابع العلماني للدولة. وتُبيّن هذه المفارقة أن عددًا من الدول الديمقراطية، لا سيما ذات الغالبية غير المسلمة، لم تلتزم بمبدأ الحياد الديني، بل نصّت في دساتيرها على دين رسمي يعكس الانتماء الديني للأغلبية، بالرغم من أن الأديان المعتمدة -كالمسيحية والبوذية- تفتقر في نماذجها التأسيسية إلى بُعد سياسي، بخلاف الإسلام الذي يتضمن منظومة من القيم ذات البعد السياسي منذ نشأته.
وتبرز النرويج مثالًا واضحًا على هذا التداخل بين الهوية الدينية والنظام السياسي، إذ ينص دستورها على أن “قيم الأمة مستمدة من تراثها المسيحي والإنساني”، ويُلزم الملك بالإيمان بالمذهب اللوثري. وينصّ دستور آيسلندا على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية التي يجب على الدولة دعمها وحمايتها، في حين يمنح الدستور السويدي الكنيسة اللوثرية صلاحيات رسمية، ويشترط إيمان الملك بالعقيدة الإنجيلية، مع إجازة تقييد حرية الأجانب في ممارسة شعائرهم الدينية. ويُعدّ هذا التبني الدقيق لمذهب ديني محدد نادرًا في الدول الإسلامية، باستثناء الحالة الإيرانية التي ينصّ دستورها على الالتزام بالمذهب الجعفري الاثني عشري.
خامسا: الصياغات الدستورية لمكانة الدين
ظلّت المسألة الدينية حاضرةً بقوة، في كل الدساتير السورية التي كتبت خلال 100 عام، منذ العام 1920، تاريخ الدستور السوري الأول وحتى دستور العام 2012. وتتعدد الصياغات الدستورية المطروحة حاليًا لعلاقة الدين بالدولة، بين من يرى النصّ على دين رئيس الدولة، ومن يرى أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع، أو الفقه الإسلامي مصدر رئيسي من مصادر التشريع، أو مقاصد الشريعة في حفظ الحياة والمال والعقل والدين والنسل مقصد من مقاصد الشريعة.
والحقيقة أن النص على مصدرية الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع قد تكون هي الأنسب في حالتنا الراهنة، وذلك لاعتبارات عدة:
أولًا: أن الشريعة الإسلامية هي معطًى إلهي متعلّق بالمفهوم الشامل للدين، في جوانبه الاعتقادية والأخلاقية والتشريعية والفلسفية، حول الإنسان والحياة والوجود، وهي ليست مجرد مصفوفة قانونية كما يتخيل البعض، ولا يمكن استلهام التقنين منها إلا من خلال آلية الاجتهاد، وهذا يُحيلنا إلى الفقه الإسلامي الذي يشكل في جوهره منتجًا بشريًا يحاول فهم النص (المحدود كمًّا) في ضوء أدوات الاجتهاد للاستجابة إلى مصالح البشر غير المحدودة.
ثانيًا: النص على مراعاة مقاصد الشريعة في المضامين الدستورية، التي تشكل الغايات الكبرى للشريعة سيضعنا في خلاف حول الوسائل الأنجع في تحقيق هذه المقاصد، وكيفية معالجتها من حيث الطريق المؤدي إلى تحقيقها، وهنا سنعود إلى التشريعات القانونية الفرعية، وهو ما يعني استعادة الفقه إلى طاولة البحث.
ثالثًا: مفهوم الفقه الإسلام مفهوم شامل للمذاهب الثمانية، ولديها آلية توليد للأحكام باستمرار، بناء على مصادر التشريع والقواعد الفقهية، وهو ما ينفي اعتبار الفقه الإسلامي مجرد مدونات تراثية غير مستجيبة لتحديات العصر.
رابعًا: النص على مصدرية الفقه الإسلامي كمصدر رئيس لا ينفي دور باقي المصادر الوضعية، كما أنه لا يعني مطلقًا أن الفقه الإسلامي هو التشريع، والفرق كبير بين أن يكون مصدرًا للتشريع، وأن يكون هو التشريع بحد ذاته، فكونه مصدرًا للتشريع يحيل إلى أن الأمر سيخضع لمداولات مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيًا، لدراسة القوانين والنظر في مدى استجابتها لمصلحة المواطنين.
خامسًا: يستجيب الفقه الإسلامي لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية للطوائف الإسلامية بشكل خاص، ويعتمد لدى هذه الطوائف على الفقه الإسلامي بعموم مذاهبه.
سادسًا: أصدرت الأمم المتحدة دراسة قانونية تقول إن الشريعة الإسلامية لديها تأثير كبير على قانون اللاجئين المعاصر، واعتبرت الفقه الإسلامي مصدر ثراء قانوني يمكن الاستفادة منه[5]، خصوصًا عندما نجد التطابق الكبير بين الفقه الإسلامي وبين القانون المدني الفرنسي.
سابعًا: إن النصّ على أساسية ومصدرية الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع لا يمكن أن يؤخذ بمعزل عن باقي البنود الدستورية التي تنصّ على الاعتراف بمواثيق حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، ولذلك لا مجال للتخوّف من أي فتاوى لها سيقات تاريخية مختلفة عن سياق الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الانتماءات الدينية.
الخاتمة
من الواضح أن الدستور، بوصفه معبّرًا عن العقد المجتمع السوري والثقافة السورية، لن يكون نسخة مطابقة للمخيال الأيديولوجي عند التيارات السياسية التي تمتلك نظريات عامة للدولة والمجتمع.
إنّ مضامين الدستور السوري التي تخصّ علاقة الدين بالدولة ستكون نتيجةً لتوافقات عميقة، بين المكونات السورية القومية والدينية والسياسية، وستكون سورية بوجوهٍ متعددة: وجهٍ يعبّر عن مدنيتها، ووجهٍ يعبّر عن ثقافتها الإسلامية، ووجهٍ يعبّر عن تنوعها، ووجهٍ يعبّر عن ثقافتها العربية، لمواجهة تحديات اقتصادية وتنموية وإنسانية تحتّم على النخب السياسية السورية حسمَ هذا الموضوع النظري بسرعة فائقة، للوقوف أمام التحديات الحقيقة التي تهمّ المجتمع السوري. ولا يمكن حسم هذا الجدل السياسي إلا بتجاوز المدخل الأيديولوجي أو استيراد التجارب الخاصة لبعض الدول المحكومة لسياقاتها التاريخية التي يعتبرها البعض نموذجًا مثاليًا بالدمقرطة. وإن معالجة علاقة الدين بالدولة، من منظور سوسيولوجي، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية للمجتمع السوري، حيث لا يُنظر إلى الدّين كمجرد طقوس أو معتقدات فردية، بل كعنصر مركزي في تشكيل الهوية والانتماء وأنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية. لذلك، فإن أي معالجة دستورية لهذه العلاقة يجب أن تُراعي هذا البعد الثقافي، من دون أن تمسّ بمبدأ مدنية الدولة أو تحوّلها إلى دولة دينية أو طائفية. فالدستور ينبغي أن يضمن حرية الأديان لكل المكونات، واحترام حرية المعتقد والتدين، ويمنع أيّ تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو مذهبي. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تؤدي هذه الحيادية إلى تجاهل الثقافة الدينية للمجتمع، بل تُترجم في نصوصٍ تحافظ على التوازن، بين مدنيّة الدولة وهويّة المجتمع. وهذه المقاربة لا تتنافى أبدًا مع عقد مواطنة متساوية بين جميع المواطنين، وهي تعزّز السلم الأهلي، والعيش المشترك، والحريات العامة، والديمقراطية لجميع السوريين على اختلاف معتقداتهم.
[1] . موقع اليوم التالي: السوريون والدستور … استطلاع للرأي نشر عام 2020.
[2] . المركز العربي: عزمي بشارة، السياقات التاريخية لنشوء العلمانية تاريخ النشر 23/05/2012.
[3] . الشاملة: كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية – ط عطاءات العلم ابن القيم مناظرة ابن عقيل الحنبلي مع أحد فقهاء الشافعية حول السياسة والشريعة
[4] . موقع مجلة “الإيكونوميست” Democracy Index 2020, The Economist Magazine Report : تاريخ النشر 2020.
[5] . الأمم المتحدة: دراسة مقارنة صادرة عن الأمم المتحدة تقول إن الشريعة الإسلامية لديها تأثير كبير على قانون اللاجئين المعاصر
نشر 22 حزيران/ يونيو 2009
تحميل الموضوع
تنويه:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
مركز حرمون




