مقابلة مع أنس زواهري، مخرج “ذاكرتي مليئة بالأشباح”
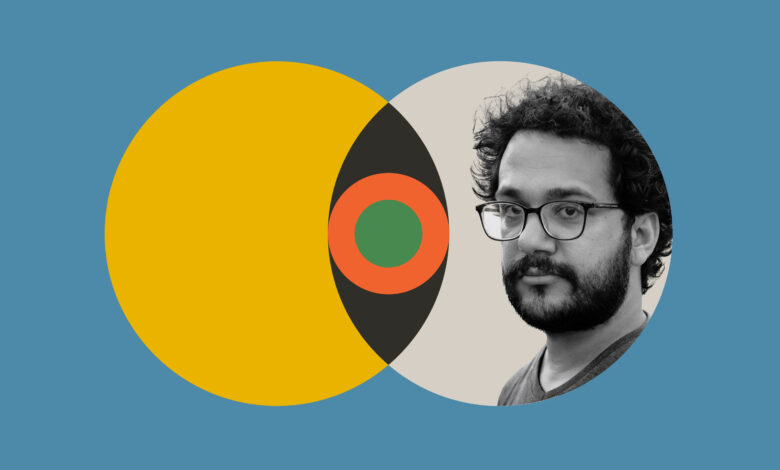
عن حمص، وصناعة فيلم في ظل آخر عامٍ من عمر رقابة نظام الأسد
05 أيار 2025
سليمان عبدالله
“كان عرضه الافتتاحي في نيسان/أبريل ٢٠٢٤. لكن لو سقط النظام قبل عرضه الأول، لكان الفيلم بالطبع قد أخذ شكلاً آخراً”، يقول المخرج أنس الزواهري في مقابلةٍ أجريناها معه، عما إذا كان سيُصدر نسخةً مختلفة من فيلمه الوثائقي “ذاكرتي مليئة بالأشباح”، لو سقط الأسد قبل انتهاء مونتاجه، ما يشير إلى عظيم أثر الرقابة النظامية والرقابة الذاتية الهادفة لحماية المشاركين/ات على الصورة التي يخرج بها الفيلم. تتوقف المقابلة أيضاً عند علاقته مع حمص، التي حاول عبر شخصياته، وهي تمضي في حياتها بصعوبة، رسم صورةٍ معبّرةٍ عن حالها.
في “ذاكرتي مليئةٌ بالأشباح” رصدٌ صبور ٌوهادئ لحياة من بقي أو عاد إلى مدينة حمص، التي تُشعرنا كاميرا مخرجه أنس الزواهري، وأصوات شخصياته الباحثة عما تتشبّث به لتكمل حياتها، بأنها باتت مدينة أشباح، فقدت قدرتها على الضحك، بعد أن أحالتْها حربُ نظام الأسد على شعبها إلى أنقاض. عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان فيزيون دو ريل السينمائيّ الدولي، وحصل لاحقاً على جائزة أفضل فيلمٍ وثائقيٍّ عربي في مهرجان الجونة. عُرض الفيلم في نهاية أبريل/نيسان ٢٠٢٥ في مهرجان “الفيلم” العربي في برلين. على هامشه التقينا أنس زواهري وكان معه هذا الحوار.
أنس زواهري، مخرجٌ ومنتج مستقل، فلسطينيّ سوري ومقيم في دمشق، أستاذ مادة السينما في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، أنجز العديد من الورشات السينمائية، عام ٢٠٢٥ تمّ اختياره للمشاركة في برنامج مواهب برلين، يتناول عمله في السينما الجانب الاجتماعي والسياسي لحياة المهمشين والمتضررين من الحروب في سوريا.
*هل خضع فيلمك لإجراءات رقابة النظام السابق المعتادة؟
لم ندخل في عملية رقابةٍ اعتيادية، لأن أسلوب العمل كان مخفيّاً إلى حد ما. بدأ الأمر بالتعاون مع مجموعةٍ شبابية ساعية للسلام عبر الفن، تُدعى ملتقى هارموني الثقافي، “تغطيها” كنيسة السريان الأرثوذكس في حلب وحماة وحمص، واتفقنا على صناعة فيلم. وهكذا عندما بدأ العمل استطعنا جلب ورقة، من خلال الكنيسة وعلاقتها مع الدولة، تنص على “تصوير عودة الحياة اليومية إلى حمص بعد الأعمال الإرهابية الغاشمة”. واستطعنا عبر هذه الورقة استصدار إذن تصوير في الشارع من محافظة حمص. خلال تصوير الفيلم، كنا نتعرض يومياً إلى تساؤلاتٍ تطالبنا بشرح ما نفعله، فنجيبهم بأننا نعمل على “فيديوهات للكنيسة”، ولم نخبر أحداً بأننا نعمل على فيلمٍ سينمائي. ومضت الأمور على هذا النحو، حتى انتهينا من صناعته.
عندما شارك الفيلم في أول مهرجان سينمائي، فيزون دو ريل، لم يكن قد مر ّعلى الرقابة في سوريا ولم يكن أحدٌ يعلم بأمره. لكن عندما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلمٍ وثائقي في مهرجان الجونة السينمائي، أحدثَ صدىً في المنطقة العربية. سمعت من عدة أشخاص، بأن عدة جهات (في النظام السابق)، خاصة مؤسسة السينما، كانت على وشك سؤالي عن ماهية الفيلم. حصلت على الجائزة في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ وسقط النظام مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر. لذا كنا محظوظين بعدم تعرّضنا للمساءلة. وكنا قد استعددنا لتقديم نسخةٍ معدلة من الفيلم إليهم، نقتطع منها كلماتٍ واضحة ك “شبيح” و”الجيش الحر”، لكن النظام سقط ونجونا.
كان تمويل الفيلم ضئيلاً للغاية يصل إلى سبعة آلاف دولار، آتية جزئياً من مشروع “هارموني” المذكور. معظم المشاركين في الإنتاج عملوا مجاناً. ذهب الجزء الأكبر من المبلغ إلى عمليات ما بعد الإنتاج.
* ما هي الرقابة التي اضطررت لفرضها على نفسك عند صناعة فيلمك هذا، رغم تواجد هذا التصريح؟
قبل صناعة الفيلم، ومن خلال تجربتنا الطويلة من التواجد في هذا المكان، وما نسمعه يومياً، كنا نعلم بأن الفيلم سيكون على هذا النحو، وليس أكثر من ذلك. لأننا كنا نعلم بأنه إن رفعنا مستوى (جرأة) ما يرد فيه، فقد تتعرض الشخصيات المشاركة فيه لمساءلة، إذ ما زالت تعيش هناك. لذا كان الأمر متعلقاً بالمبادئ والأخلاق في تعاملنا مع الشخصيات، التي كنا نخبرها أننا نقوم بعملٍ لا يعرّضها للخطر في المستقبل. لم يكن الأمر يتعلق بي، حتى لو خرجتُ من سوريا، كانت بقية الشخصيات موجودةً في الداخل.
وهكذا حذفنا الكثير من الأحاديث الواضحة عن النظام خلال المونتاج. واضطررنا أن نحكي بقليلٍ من الحياد حتى لا نعرض الشخصيات للخطر، لكن في الوقت نفسه، على نحوٍ يستعرض المضامين القوية ضد المنظومة التي كنا نعيش فيها. كنا نحاول على طول الخط ألا نصنع فيلماً من دون مضامين. وبسبب الرقابة، كنا نصل إلى الخط الأحمر ونمشي بموازاته.
*يقول لكَ أحد المشاركين في الفيلم: “فينا نحكي كل شيء؟”، حصل …
نعم حصل الكثير من الحذف هنا. كانت الشخصيات تتحدث دوماً عن السلطة وكيف يتعامل نظام الأسد معنا، لكن مجدداً، وكي نحميهم، حذفنا الكثير وركزنا على قصتهم الشخصية، بعيداً عن مواجهتهم مع المجتمع والسلطة. كنا قد جهزنا أنفسنا للعب دور المحايد، والدفع بأننا نسرد حكايات الناس ونجاتهم بعد الحرب، ولا نحكي عن النظام. لذا كنا نهدف الوصول إلى العمق من دون أن يكون مباشراً، لكوننا نعيش تحت سلطة هذا النظام، الذي كنا موقنين حينها بأنه باقٍ إلى الأبد.
*يُفهم من كلامك بأن مونتاج الفيلم كان قد انتهى قبل سقوط النظام، ولم يكن هناك مجالٌ لإصدار نسخة أخرى؟
نعم، كان قد عُرض حينها وحصل على عدة جوائز، وكان من الصعب أن نغيّر فيه. كان عرضه الافتتاحي في نيسان/أبريل ٢٠٢٤. لكن لو سقط النظام قبل عرضه الأول، لكان الفيلم بالطبع قد أخذ شكلاً آخراً.
*تُرى الرقابة من قبل البعض على أنها محفز ٌ على الابداع في السرد، والابتعاد عن المباشرة. كيف تنظر إلى الوضع مع سقوط الرقابة نظرياً في سوريا، وتوفر خيار التناول المباشر؟
اعتقد أن المباشرة تضرّ الفيلم على أية حال، وأنّ السينما هي كيف تريد أن تحكي، بأسلوبٍ معين، وبلغة خطابٍ جيدة. وبذلك، إن أردت الحديث بشكلٍ واضح ومباشر عن الأمور، لن تكون سينما. الآن ومع زوال الرقابة السابقة، وأنا أعمل على فيلمي الجديد، لا أُفضّل المباشرة، لأنها تؤذي أيّ عملٍ فني.
في المباشرة سهولة، وهو ما لا يحبه الجمهور، إذ لا جديد فيها، نحن نضيء لهم على نقاط معينة، قد تكون غائبة عنهم. لذا حتى إن كانت المباشرة متوفرة، فهي ليست خياراً، لكونها تحوّل العمل إلى تقريرٍ إخباري.
*يبدأ فيلمك بمقولةٍ ذاتية، عن عودتك شخصياً إلى حمص. تعتمد على اللقطات الطويلة والكوادر الثابتة المتوسطة والبعيدة، هل لك أن تحدثنا عن قرارك في البداية عما إذا كنت ستصنع فيلماً موضوعياً أم ذاتياً، قد تكون جزءاً منه؟
أنا ابن مدينة حمص، وعشت فيها طوال حياتي. خرجت منها في ٢٠١٩، وعدت إليها في ٢٠٢٣ لأصنع الفيلم. فعلياً، الفيلم لا يحكي عن حياة الشخصيات الظاهرة فيه فقط، بل يسرد حكاية المدينة ككل. بمعنى، عندما اخترنا الشخصيات التي نريد أن نحكي عنها، كان الهدف ليس التركيز على قصصها فحسب، بل أن تكون هذه القصص معبرةً عن الكثير من سكان المدينة، لذا كان الهدف سرد حكاية المدينة ككلّ، بورتريه لهذه المدينة بطريقة ما.
تغيّرتْ علاقتي بحمص عما كانت قبل صناعة الفيلم. علاقتي بهذه المدينة هي كعلاقة الشبح. هربتُ منها، وكنت أراقبها من بعيد، محاولاً ألا أنخرط فكرياً أو عاطفياً معها. الفيلم يُظهر كيف أنظر إلى المدينة من دون الغوص في تفاصيلها. لم يكن هناك حيّزٌ كبير لمشاعري حيالها في الفيلم. هكذا كنت واحداً من هذه الأشباح التي ما زالت فيها، الأحياء منهم وأولئك الذين رحلوا.
*لا نشاهد المشاركين/ات في الوثائقي يتحدثون، هل كان تسجيل أصواتهم وعرضها لاحقاً رفقة مشاهد مصورة بشكل منفصل، لكسب ثقتهم بعيداً عن حضور الكاميرا، أم تعلق الأمر بمقاربتك تقديم حمص كمدينةٍ يتحدث سكانها كأشباح؟
لم أسجّل مع الشخصيات لفترةٍ طويلة، تبادلنا الأحاديث أولاً، وبعد أن كسبت ثقتهم، وعرفوني جيداً، وكيف أعمل، وبأنني لن أضرّ بهم، حصلتُ على لبّ ما يريدون قوله خلال جلسةٍ أو اثنتين. جاءت فترة البوح في آخر مراحل انجاز الفيلم. ولم تكن هناك كاميرا في غالب الأحيان. وحين كانت الشخصيات تتواجد، لم تكن الكاميرا حاضرة. غالباً تتواجد الشخصيات في فضاءٍ منعزل. الشخص المتعرض لتراوما لن يستطيع قول ما لديه بوجودها، ومن الصعب عليه عموماً البوح بها لأيٍّ كان. لذا كان أفضل خيارٍ هو عدم وجود كاميرا وهم يتحدثون.
*ما هي الأفلام التي ألهمتك خلال العمل على هذا الفيلم؟
أعمال شانتال أكرمان في السينما الوثائقية، التي كانت تعطيني أفكاراً وأشكالاً ومضامين. لديها فيلم يدعى “من الشرق”، تصوّر فيه لحظة سقوط جدار برلين من الشرق إلى الغرب. كان ملهماً لي، من الناحية البصرية نوعاً ما.
*ما هو الفيلم الذي تعمل عليه الآن، وهل هناك أي نمطٍ من الرقابة في سوريا الجديدة؟
موضوع فيلمي القادم حسّاسٌ قليلاً، فهو يحكي عن المغيبين قسراً، من وجهة نظر الأمهات، وأثر هذا التغييب على حياتهن، وهذه الحالة “الشبحية” التي كانت موجودةً أيضاً في فيلمي الأول.
نحن الآن في مرحلة البحث والتطوير. حصلتُ على دعم، وسأبدأ ورشة تطوير ،مدتها عامٌ كامل. باتت الخطوات الأولى نحو انجازه واضحةً بالنسبة إليّ.
لا نعرف ماهية الرقابة الجديدة وحدودها، لأنه لم يصنع أحد فيلماً بعد السقوط حتى الآن. لكن سنعمل ونجرّب ونرى. المؤسسة العامة للسينما مجمّدة النشاط حالياً. الوضع غامض. بصرف النظر إن كنا متفائلين أم لا، نتوقع الأفضل، كي لا ننهار كلياً.
حكاية ما انحكت




