التجريد وذاك الهسيس الخافت.. حوار مع الفنان التشكيلي السوري عبد الله مراد
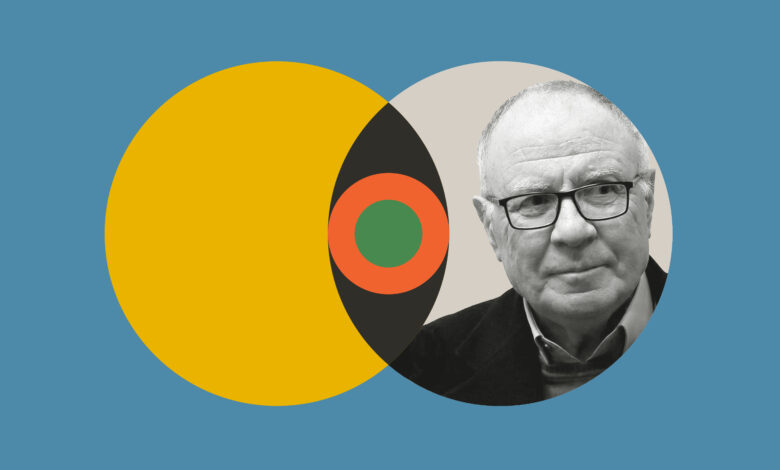
محي الدين ملك
06 أيار 2025
في كتابه المثير “هسهسة اللغة” يذْكر رولان بارت نوعاً أخر من القراءة، هكذا: “رافعاً الرأس”، عند قراءة أي نص، أو الاستماع.. ومردُّ ذلك ليس “لعدم الاهتمام من جانبنا، وإنما على العكس، تدفقاً للأفكار والإثارات والتداعيات”.
هذه العبارة تتضح أكثر في التجريد، ومعه. يرى كاندنسكي، رائد التجريدية ومؤلف كتاب “الروحانية في الفن” أن “الروحانية التي يشكل الفن عنصراً من أهم عناصرها تتمثل حركة مركَّبة .. تمضي إلى الأمام وإلى أعلاه.. حركة تنشأ من حبَّاب العرق، من الآلام، والمخاوف، من مقاومة الحواجز، والعوائق، وأشواك الشر المتجدد، وعتمة الطريق”.
وإذا ما دققنا النظر في الكلمات، وفي الصفحات التي تحكي عن التجريدية التعبيرية لوجدنا أن خلاصة التجريد في الشوق، وما يتبعه من “حنين”.
كل تجريد هو حنين، يكشف عن مشاعر وأفكار وتداعيات ترصد المرئي في اللامرئي بعد تعريته وجرْده من الزيادات، ومنه عطفُ حالةٍ خاصةٍ على حالةٍ عامة (شكلاً أو مضموناً).
والعمل بصمت، هو أكثر التجليات حدة لتجربة الفنان عبد الله مراد ولتأملاته. وفي هذا السياق، ليس من الصدفة أن يصف نفسه على النَّحو الذي يراه هو: “أنا مجرد رسام ينحو نحو الصمت قدر الإمكان”.
هذا الحوار يضم أجوبة في منعرجات سيرة حياة بلغت من العمر الثمانين، وسردٌ يُبيِّن تطور تجربة فنية تستقصي عوالم بدأت من زمنٍ أليفٍ إلى زمنٍ جريحٍ، إلى حربٍ وخرابٍ، وإلى فقدانٍ يضيء الألم. ثم اهتداء إلى مسار الفن العربي والسوري، الحديث، من نظرة شخصية.
كل هذا، يحكيه الفنان، ببساطة، ويبقى المعنى في قلبه، فما لم يَقُلْه، نراه يخفقٌ تحت طبقة لونية، أو مع خط هارب أو منضبطٍ في لوحة تستبقُ فِعل الكلام.
أُجري هذا الحوار في دمشق، قبل سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
المُلاحظُ في الكثير من لوحاتك كأنها لم تنتهِ بعدْ، بل ولا تريد أن تنتهي، سيَّما أن لكل شيءٍ بدايته ونهايته، واللوحة كذلك، بالمفهوم الفني (التكوين)، أو وكأنك ترغب في أن يبقى باب اللوحة مفتوحاً، دائماً، لتراها على الدوام، خارج القراءات الكسولة؟
ربما، لأنني بطبيعتي، شخصٌ متردِّدٌ، ومسكونٌ بقلقٍ مستمرٍ لا يهدأ، ودائماً أبدو في حالة المراجعة والتقويض، أطمح أن أُنجز المزيد والمزيد من الأعمال الفنية بطريقة الإيجاز والاختزال والتبسيط. لذلك، عندما أرسم، أشعر وأرى أن ثمة أشياء تخرج منّي وهي زائدة عن حاجة اللوحة، وربما زائدة عن حاجتي، أيضاً، لكن، عندما أعود إليها مُجدداً، أقوم بفعل المحو والحذف كثيراً، بل وأضيف أشياء جديدة – قليلاً. عندما يُحْذفُ من اللوحة الكثير فإنها تكتسب حضوراً قوياً، وتعطي لنفسها وضعاً متميزاً، بل ويتسع أفق القراءة.
هل لتردُّدك وقلقك، وما تقوم به من عمليات المحو والحذف علاقة ببناء الشكل الفني أم هي هواجس تأتيك لغرضِ مضمونٍ مُعَيَّنٍ تسعى للإيقاع به؟ بمعنى آخر، ما هي الخلاصة التي تريدها من التجريد / وبه؟
سؤالك صعب، صعبٌ جداً. لو كنتُ أعرف ما أريد لاسترحتْ. على كُلٍّ، أراني مُنفلتاً من كل النظريات والآراء، إن كانت ماركسية أو سواها من الرؤى، ربما أجدني أقرب إلى “روحانيات صوفية” لكن في سياق مختلف له علاقة بناحية الفن التجريدي، ومن دون معرفة عميقة بالصوفية، أي في نِطاقٍ مُتَخَيِّلٍ إبداعيٍّ، حيث أنصت من خلال الخطوط والألوان إلى ذاتي.
بهذا المعنى، عندما أدخل إلى اللوحة، كأنني في غواية مجهولة، أدخل إلى عوالم أشعر بها وأراها للمرة الأولى، كحالة لا يمكن التَّعرُّف عليها بسهولةٍ، ولا أكتمُ سراً إن قلت إنني أكتشف “العُقَد المريضة” أيضاً. (يضحك بشيء من عدم الرضا).
في هذا السياق، وفي صورة تقريبية تُلخِّص المعنى الذي أُحاول أن أشرحه، أتذكر لوحات الفنان الأمريكي روتكو التي لا تعبر لوحاته عن شيء سوى عن الصمت الرهيب، وفنانين آخرين قاموا بالاختزال والاختصار، فقط، في محاولةٍ يصلون عبْرها إلى جوهر شيءْ ما، يأتي ندائه من بعيد.
جميل. أيضاً، وعلى غير العادة، يتَّضح للمُشاهد عدم اهتمامك بتأسيس اللوحة وبأناقتها، في صورة بعيدة عن التنميق السائد للمظهر. هل توافقني؟
صحيح، إلى حدٍّ ما، لأنني أعمل بحرية وتلقائية مُفرطة، وأحياناً أهتم بالتَّكنيك والتقنيات بطريقة عفوية دون اعتبارات سابقة، للتعبير عن فوضى العالم. ربما، من هنا، لا أهتم بالمظهر الخارجي، أحياناً.
هذا التَّصوّر يجعلني أتوجه نحو مسألة أخرى: هل تشعر بحالة من “التشيؤ” على اعتبار أنك تبحث وتتحسس أمالك أو آلامك وفق قواسم تشكيلية مشتركة بين كل الكائنات الحية وبين الأشياء الجامدة، بين هندسة الطبيعية والمدن المنهدمة، بين لحظة حرّة وواقع يزداد حصاراً؟
أؤمن بوحدة واحدة بين الجميع.
بمفهوم الصوفية؟
نعم، “وحدة الوجود”.
على طريقة “ابن عربي”؟
نعم. والدليل هو لوحةٌ قمتُ فيها برسم مقام “ابن عربي”. دائماً أزور هذا المقام، ليس من باب التَّدين، فأنا لستُ مُتديناً، بل أندمج كثيراً مع هذا المدِّ الإنساني الواسع.
بشكل عام، أرى من الأفضل ألا يحكي الفنان كثيراً، بل، يعبر – فقط – بالخطوط والألوان، أما كلامه عن اللوحة فلن يكون واضحاً ومشروحاً بالشكل المطلوب. الكلام عن اللوحة مَنْقَصة في حق الفنان، وفي حق اللوحة، أيضاً.
رأيك قريب من تفكير الفيلسوف التائه جاك دريد وهو الذي قوَّض التراث الفلسفي الغربي، وعندما لم يجد حقيقته فيه، ذهب إلى الهوامش، واستعان بـ “القلة”.
صحيح. لكن الكلام موهبة، والحقيقة أنني لا أُجيد هذه الموهبة، وأعترف بأنها “عقدة نقص” عندي، خاصة أنني لا أجد القدرة الكلامية الكافية لشرح وتفسير لوحاتي. أرسم في تلك الزوايا الخفية التي يصعب الكلام فيها، وعنها.
هذا رأي أستحسنه، وأتفهّمُهُ من مقاربةٍ سريعة – إن جازت المقاربة – بفنانين يتحدثون عن أنفسهم وعن لوحاتهم كما لو أن الزمان لم يأتِ بمثلهم. ربما من أسباب هذا الحالة هي غياب التفكير النقدي – الفني – الصحيح. هل أخطأتُ أم أصبتُ؟
صحيح. وللإضافة، أقول: منذ صغري تعلمتُ أن أرسم، واليوم، تتحرك يدي بعفوية وتلقائية، من دون قيدٍ أو شرط، بل ومن دون أن أُفكر، وربما، من هنا، يمكن القول، أيضاً، أن الكلام لا يُعنيني.
كلامٌ جميل..
حسناً، على ذِكْرِ الطفولة، دعنا نستعيد منها بعض السَّرديات المُعلَّقَة بذاكرتك البصرية، لأنني أشعر من كلامك وخلال تأملِ لوحاتك بأن هذه المرحلة هي الينبوع الأول، والأُلفة الأولى التي تُركِّز عليها في لوحاتك، بشكل مُحاطٍ باللذة والمغامرة معاً، وأعتقد أن ذاكرتك البصرية تمنحك أحسن وأجمل الصور الفنية التي تُعيد إنتاجها بعفوية بعيدة عن التزلُّفِ والاستعراضِ والمهارة.
(بعد صمت طويل) كانت طفولتي حلوة، مع أنني من أسرة متواضعة. والدتي لبنانية، وكنا نذهب إلى بيروت، أيام الصيف، عند أهل والدتي الذين يُقيمون هناك. كان عمري وقتذاك خمس سنوات، تقريباً، وأتذكر أحراش الصنوبر وصوت حفيفها، والبحر بموجاته التي لا تنهني: موجة فوق موجة. وفي نهاية الصيف، نعود إلى حمص. واليوم، أتذكر كم كانت الحياة جميلة ومتنوعة في الماضي، ومنفصلة عن “الحاضر” كُلِّيَاً!
والدي، رحمه الله، كان قارئاً جيداً، أراه دائماً يحمل بين يديه كتاباً أو جريدة، وهو الذي اكتشف ميلي وشغفي إلى الرسم، فشجَّعني بشكل لا يُصدّق. أذكر كيف أخذني إلى مكتبة “الزهراء” المعروفة – في تلك الأيام – في مدينتنا حمص، ولازلت أذكر اسم صاحبها، وهو بهاء دياب. طبعاً، لم يعد للمكتبة من وجود، بل صار أثراً بعد حين. بهاء، كان إنساناً مثقفاً، ورقيقاً، وطيباً، يبيع في مكتبته الألوان وأدوات الرسم التي لن تجد مثلها في هذه الأيام، خاصة الألوان اليابانية المُميَزَّة جداً، إضافة إلى الكتب الثقافية المتنوعة. المهم، قال والدي لبهاء: أعطِ ما يحتاجه عبد الله من ألوان ودفاتر ومجلات، في الوقت الذي يريده. طبعاً، بدأت أشتري الألوان والرِيَشَ ودفاتر الرسم.
والجميل هو أنني صرت أذهب إلى المكتبة كل أيامَ الخميس، لشراء مجلة “سندباد” الرائعة جداً، التي تحوي على رسومات بديعة للفنان المصري الكبير حسين بيكار، وفي البيت كنتُ أنقلُ من تلك الرسومات إلى دفتري، أو أرسم من خيالي الغضِّ، ولن أنسى تلك اللحظات السعيدة التي كانت تنتاب والدي وتغمر روحه وهو يتأملني وأنا الرسم. لحظة مُتهجِّجة في جهة ما من ذاكرتي، لا يمكن تصوُّرُها، ربما هي موجودة في لوحة ما، حقيقة!
وللمعلومة: كنتُ الطِّفل المدلل في البيت مع ثمانية أخوة: أربعةُ صبيان وأربعُ صبايا.
ترتيبك بين إخوتك؟
الأول.
أكمل لو سمحت..
في المدرسة، والحق يُقال، لم أكن متميزاً، كنتُ ضائعاً بين الرسم وأحلام اليقظة وغراميات الطفولة (يضحك بعمق)، ثم أنهيت المرحلة الثانوية، ودخلت كلية الفنون الجميلة، في عام 1965، وتخرَّجت في نهاية السبعينيات.
ماذا كان موضوع تخرُّجك؟
عن البحر.
توقّعت، بدليل ليونة اللون، وانسيابية الخط، وحساسية الأشياء التي تُحاكيها، وتُكوِّن الشكل النهائي لتكويناتك الفنية المتمرِّسة على عالم البحر وعوالمه.
نعم، نعم. ولكن، لا أعني بالبحر الصيادين والمراكب، بل روح البحر.
تُذكّرني بالشاعر الفرنسي.. (يُقاطعني)..
سان جون بيرس، وديوانه الشعري “منارات”. يقول فيه:
ضيِّقة هي المراكِب ضِيقَ سريرنا
لا حَدَّ لامتداد المياه، وأكثر اتِّساعاً مملكتنا
جميل، تابع..
كنت طوال عمري أهتم بالقراءة، ليست بطريقة مُنتظِمة، وإنما للمتعة. أقرأ الشعر الحديث / العربي والمترجم، والمسرح، ولا أنسى كتاب “واقعية بلا ضفاف” لروجيه غارودي، كتاب مُدهش! أذكر أنني كنت أقول لأصدقائي الماركسيين: خذوه، ففيه روح الماركسية وجمالياتها!
طيب، هل من ومضات أخرى، من تلك السنوات البعيدة، لايزال لها بريقها الذي يُنعش عالمك الجوّاني، وتُحَقِّقُ بها التوازن، في أيامك هذه، أعني من ناحية الرسم؟
سؤال حلو، والجواب من هذه البداية: في حمص، كنا “شلة” أصدقاء رسامين، أمثال عبد القادر عزوز، وكرم معتوق.. وغيرهما، وكنا نخرج إلى الطبيعة، لنرسم اللوحات بالألوان المائية والألوان الزيتية، ونسهر، ونتبادل الزيارات، والأفكار، والهموم، والهواجس. هذه من اللحظات التي لا أنساها، كحالة اجتماعية أو كصداقة تلك كانت موجودة وانتهت بموتهم!
أيضاً، في فترة الثانوية، كنت أتردد إلى مركز الفنون التشكيلية في حمص، وكان الفنان والأستاذ أحمد دراق السباعي، وعبد الظاهر مراد، وصبحي شُعَيب، وغيرها من الأسماء المهمة ولها الأثر الباقي، لأنهم حبَّبونا بالفن، وشجَّعونا كثيراً عليه.
وأيضاً، كانت لكلية الفنون وأساتذتها آثارها، أمثال محمود حماد، وفاتح المدرس، ونذير نبعة، وإلياس الزيات، هؤلاء كانوا أكثر من كونهم أساتذة، كانوا نُبلاء وإنسانيين، ومتفانين في فنهم ومهنتهم. نُبلاء، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ويكاد زمننا الحالي يخلو من أمثالهم، وهذا الأمر يجعلني أتَحَسَّرُ وأحزن.
لنكتفي عند هذا الحد من الجواب، كي لا أثقل عليك.
أريد أن أستفسر عن مسألة أخرى، وهي أنك تُعدُّ من أهم الفنانين التعبيريين والتجريدين، وهذا صحيح وجَليٌّ، لكن، إلى أيِّ حًدٍّ أنت مع هذا التَّقييم؟ أو كيف ترى نفسك؟
لا أُعوِّلُ على التصنيفات، ولا على الكثير الكثير من الآراء التي تخصُني أو تتعلق بتجربتي، لماذا؟ لأنني في شَكِّ دائمٍ ومستمرٍ في قدراتي الفنية، وقد يُقال أنني مشهور، واسمي معروف، كما يتردد في الأوساط الفنية، لكنني أجد نفسي متواضعاً جداً، ولا أُبالغ في تقدير حجمي، إطلاقاً. أنا إنسان يبحث ويُجرِّبُ، وسعيدٌ في حدود هذا البحث والتجريب. العمل الكثير يُريحُني، وأُحاول أن أكون قريباً من الحداثة، أعني التلخيص والاختزال والتبسيط، والغاية كلها للوصول إلى لوحةٍ متماسكةٍ من حيث التكوين، ومنسجمة في علاقاتها اللونية.
فاللوحة كالعمارة، أي، لها هيكلها الأساس، ثم تأتي الأجزاء والتفاصيل اللاحقة تباعاً، وبذلك يكتمل البناء الفني، بشكل نهائي، لكن بشرط أن أكون راضياً ومُقتنعاً من النتائج النهائية، بمعنى، لا بد أن تتشكَّل عناصر اللوحة ودلالاتها وفق رؤيتي البصرية وحالتي النفسية.
أمر آخر مهم، وهو أن لوحاتي – بنظرة عامة – مُقتبسة من الجسد الإنساني، بتفاصيله وصفاته: الانحناء، والليونة، والحركة، والتَّشظي.. مع عناصر أخرى أستمدها من الطبيعة، ثم أقوم بعملية المزج بينهما، والبحث عن التناغم والانسجام. بمعنى آخر، أبحث عن العلاقة الفنية التي تجمع بين الكائنات الحية وبين الجمادات، مثلاً: العلاقة بين حيوية الشكل الإنساني وجمود الصخرة، أو الجبل.. إلخ.
أعذرني، فقط، للتوضيح، هل ترى أن الطبيعة جامدة بلا حياةً ولا حركةً؟
أبداً، لكنها تبدو لنا جامدة، وهذه مفارقة مثيرة: في الشجر حياة، وفي الصخور كذلك، والجُسيمات المليئة بالطاقة، تعمل وتتحرك وتفعل فعلها في كل ذرة، بصمت، ومن دون أن نتحسسها أو نراها!
حسناً، دعنا نُنقِل هذه الرؤى إلى جانب تقنيٍّ، وهو “الملمس”: الخشن أو اللَّين، السميك أو الرقيق، الفاتح أو الغامق.. إلخ. معلومٌ الدور الذي يقوم به هذا العنصر التصميمي في بناء اللوحة وإظهار عوالمها المتباينة، لكن، ما يهمني هو علاقته بالجانب النفسي – الفني عندك؟
نعم، هو في الإطار التقني، ولكن، بالتأكيد، لا يمكن إلغاء الجانب النفسي، إلا أنني لا أمتلك القدرة على شرحه، ومع ذلك، سأحاول: لا أنكر الجانب المعرفي وتراكم الخبرات الفنية، وما يُعنيني في هذا الإطار هو أنني – على سبيل المثال – لا أضع اللون كما هو، بل أقوم أحياناً بمعالجته أو إحداث خدشٍ فيه، حتى أحصل على الملامس والدرجات المتباينة والمتنوعة، والتي أريدها، وفي النهاية يظهر المطلوب، بالمهارات الفنية، شَرَطَ أن يُشعِرُني بالعفوية والتلقائية.
نعم، ولهذا الأمر تداعياته ومتطلباته النفسية، ولا أعتقد أن حالتنا في وضعٍ صحيٍّ سليمٍ، بل هي مليئة بـ “العُقَد النفسية”، ولا شك أن لهذه الحالات أثرها على إبراز الملامس على سطح اللوحة.
بكلمة واحدة: حقيقة، أنا أجهل نفسي. لهذا، ربما يمكنني القول: إن الفن لا يخلق مع كائنٍ سويٍّ. الفن أقرب إلى اللامألوف.
بالتوازي مع الجملة الأخيرة، يخطرُ في خاطري عبارة مناسبة، قالها الفنان “جيريكو”: يجب أن تعيش في العالم وكأنك تعيش في متحف ضخم من الغرائب.
فعلاً، هو ذاك، ذلك أن الإنسان مُثقلٌ بالآلام، ويشعر بالحيرة أمام الوجود، حيرة تضعهُ في موضعٍ قاسٍ من ألمهِ، فيصمت. ربما هي الصدفة هي التي جعلت الفن شَغَفي، وبهِ أبحثُ عن السعادة وعن التوازن. عندما أرسم، أنفصل عن الواقع وعن كل العالم المحيط بي، لأتعايش بخيالي مع الشكل واللون.
إذاً، حدثني عن لحظة المواجهة بينك وبين المساحة البيضاء / اللوحة؟ كيف تفكر؟ ما الذي يخطر في بالك؟ وما هي الأشياء التي تريد أن تُحولها إلى أشكال لها دلالات؟
سؤال جميل. عندما يحين وقت الرسم، أشعر كأنني – ولأول مرة – أقف أمام المساحة البيضاء الفارغة، أو أواجه هذا الفراغ الكبير. دعني أُوضِّح الصورة بمثال: عندما أقف أمام اللوحة كأنني واقفٌ أمام امرأة في غاية الجمال، فأنسى كل تجاربي السابقة، وأبدأ أُفكِّر بها، وحدها. تماماً، هكذا أكون أما لوحة فارغة وأنا أنوي الرسم عليها، وأبدو في جهلٍ تامٍ بالخطوط والألوان التي ستخرج منّي، ولكن، الأهم هو الحالة العفوية والعشوائية، ومن دون تردّد.
ثم، في المرحلة التالية، أي بعد أن تتشكَّل عوالم اللوحة، أعود إلى التصحيحات والتصويبات اللازمة، أعني الحذف والمحو والإضافة، إلى أن أصل إلى قناعةٍ بصريةٍ مِنْ أنَّ اللوحة قد استوتْ، وبلغتْ مُنتهاها. وهنا أريد أن أعترف بشيء، وهو ليس باستطاعتي دائماً الوصول إلى النهايات المقنعة والسعيدة، بل وأعترف لك أنني أفشلُ في إنجاز اللوحة، أحياناً، ربما لأسباب نفسية، أو ربما من خطأ تقني وقعتُ فيه، ولا أعرف كيف؟ ومتى؟ وأين؟
أُفكِّر بكلامك داخل الإطار النفسي، ووفق الطبقات اللاواعية، لذا، سؤالي هو: هل سبق وأنْ ظهرتْ في اللوحة حالة معينة، واكتشفت مدى حساسيتها أو غرابتها، فقمت بمحوها أو تغطيتها؟
هذا الأمر واردُ جداً، والأكيد أن ثمة أوامر أو موانع نفسية تصدر عن عالمك الداخلي القَلِق، وبالتالي، تستدعي منك الحذف.
لو دفعنا بكلامك هذا نحو يومياتك المعاشة، وحياتك الاجتماعية، ماذا تقول؟
لست كائناً اجتماعياً إلا في نطاق ضيِّقٍ، وأصدقائي محدودي العدد، رغم أن الناس يحبونني، وهذا شيء أُقَدِّره من قلبي، لكن، يبدو لي أنني أُحب العزلة، وأفضل أوقاتي عندما أكون لوحدي، مُكتفياً بـ / ومع نفسي.
طيب، جوابك يُحيلني إلى هذه الملاحظة: يبدو لي في لوحاتك التي تعود إلى المرحلة التعبيرية، وكأن شخصياتك تعيش في مناخ “كافكاوي” – نسبة إلى الكاتب “فرانز كافكا”. هل في ملاحظتي جزء من الحقيقة؟ ثم لو تحدِّثني قليلاً عن علاقتك بالتعبيرية.
كافكا (خَرَّبْ حياتنا – بالعامية) من خلال رواياته: القضية، والمحاكمة، والقلعة، والمسخ.
(بعد صمت..) قبل مرحلتي الجامعية، وأثناء فترة تَعَلُّمي الرسم في مركز الفنون التشكيلية بحمص، لم أكن أهتم كثيراً بأناقة الرسم، ثم لا أملك الصبر الكافي لرسم التفاصيل بأسلوب الرسم الواقعي، بل كل اهتمامي كان مدفوعاً نحو الطاقة الانفعالية، والإيقاع الداخلي، من خلال ضربات الريشة القوية، والجرأة أثناء العمل.
في المرحلة الجامعية، كنت متأثراً بالفنان جورجيو موراندي، سيد التقشف في اللون، وبول كليه، ونيقولا دوستاي.. إلخ. للتوضيح، قلت: تأثرت بهؤلاء، ولم أقل: قَلَّدْتُّ هؤلاء، بمعنى، أتمثل بعض الأشياء الجميلة التي تهمُّني، ثم أعيد إنتاجها بطريقتي الخاصة.
لننتقل إلى موضوع آخر، أعني المأساة الرهيبة التي حلتْ، والحرب التي أتت على البلاد والعباد. كيف تصف آثارها عليك وعلى تجربتك الفنية، والانتقال من مرحلة فنية إلى أخرى؟
خراب شامل أتى على البلد، فتضرر الكل. وأقول صراحة إن الظلم موجود، والقسوة بلغت حدَّ الإفراط، في البداية، ثم من جميع الأطراف، وعندما بدأت الأحداث تأخذ طابعاً دينياً، كان هذا يعني أن الكارثة قد وصلت إلى الـ “مقتلة”.
لا أريد أن أخوض كثيراً في مقدمات الكارثة ونتائجها، فالأمر بات معروفاً، لكن، من جهة أثرها – فنياً – أقول: رسمت أعمالاً عبِّرتُّ فيها عن الحالةِ بشكلٍ مباشرٍ. والحق، أن تاريخ الإنسان مليء بالحروب والمآسي، والفنون جميعها لم تستطع منع حدوث مثل هذه الكوارث البشرية. يبدو أن الشرَّ هو الغالب.
أكرر، ما جرى في سوريا مؤلم جداً، وسوداويٌّ: مدنٌ مُدمرةٌ، وعنفٌ لم يكن له مبرر، ولم يكن له مثيل. هل تتخيل بلداً كان واحداً ثم تشظى وتجزأ؟! وهل تتخيّل أولئك الذين فقدوا أحبابهم، وما أكثرهم، وأنا منهم، لقد فقدتُّ “ابني” “الوحيد”؟! لكن، ما يدعوني إلى الصبر والمواساة هو أن أكثر السوريين هم مثلي، وأنا مثلهم! حالة فظيعة لا يمكن تصوُّرها ولا تصديقها، ولهذا، أتجنب الكلام عنها وعن أثرها عليَ!
حسناً، أُقدِّر شعورك، فعذراً، وأشكرك على تحمّلِك عناء الحديث في أمرٍ لا يمكن وصفه بالكلام.
بقي عندي بضع أسئلة في عموميات الفن:
قراءتك لواقع الفن التشكيلي العربي عموماً، والسوري على وجه التحديد؟
أرى أن الدول التي تأثرت بأوروبا (مغرب، جزائر، تونس، لبنان) أنتجوا فناً. كذلك العراقيين، وبحكم حضارتهم القديمة فقد أنتجواً فنّاً هاماً، هو مزيج من الفنون القديمة والحداثة. ويبدو لي أن الصراع الذي حدث في تاريخ العراق كان من نتائجه أن ظهر فنانون متميزون، بدءاً من “الواسطي” و”بهزاد”، وهما من عباقرة رسامي المنمنمات في الفترة العباسية، إلى الفترة الحديثة، مع جواد سليم، وشاكر حسن آل سعيد..
في مصر، أيضاً، ظهرت تجارب فنية رائدة، على يد فنانين كبار، أمثال: آدم حنين، وعبد الهادي الجزار، ومحمود مختار، وراغب عياد.. ولكن، يبدو أن الأمر قد تغيَّر، أي كأن الفن المصري الحديث اليوم في حالة انحدار، أو هبوط، إلى حدٍّ ما.
وفق هذا الكلام، ألا تعتقد أن للسياسية دورها السلبي في مآل الفن؟
أكيد، ولا شك في ذلك.
طيب، أكمل..
في سوريا، ومن الناحية الإبداعية، توجد تجارب فردية هامة، مثل تجربة الرواد من الجيل الأول والثاني، عموماً، ولاحقاً، ظهرت تجربة فاتح المدرس، ثم تجربة يوسف عبد لكي.. وفادي يازجي.. إضافة إلى فنانين متميزين، خارج سوريا، مثل زياد دلول.. وفنانين شباب من الجيل الجديد.. وأسماء أخرى وكثيرة، لا أتذكرها الآن.
تكمن المشكلة في غياب الحركة الفنية. وبكل الأحوال، لا يمكن الحكم على مرحلة فنية، أو على تجربة فنية، من مرحلتها الآنية، بل يحتاج الأمر إلى فترة زمنية معينة، حتى تتوضَّح معالمها أكثر، ومدى أهميتها، ومعرفة سماتها.
رأيي فيما يتعلق بالنقد السوري يكاد يكون سيئاً جداً، لأن النقد سيء، بل لا يوجد نقدٌ، أصلاً.
عموماً، باعتقادي، تبقى تجارب فن التشكيل السوري متواضعة مقارنة بالتجارب الأوروبية. لا يوجد فنان تُضاهي تجربته تجربة جورج براك، مثلاً. أيضاً، مقارنة بفنون آسيا (الفن الصيني، والفن الياباني). بالمختصر، كانت للمنطقة فنونها العظيمة، هذا بالنسبة للتاريخ القديم، أما اليوم، فنحن مبتدئين في هذا المجال العظيم.
كيف تنظر إلى غياب التفكير النقدي – الفني السليم وهامشية الدراسات “الجمالية”؟ أو هل يوجد ما يمكن أن نطلق عليه “نقداً”؟
رأيي فيما يتعلق بالنقد السوري يكاد يكون سيئاً جداً، لأن النقد سيء، بل لا يوجد نقدٌ، أصلاً.
لا أُحب أن أسيء إلى التجارب الفنية وللأصدقاء الفنانين، وهذا الجانب الاجتماعي والخاص لا شأن له بموقفي من النقد التشكيلي. إذاً، إنْ كان مِنْ نقدٍ فنيٍ، فهو نقدٌ سطحيٌّ واستعراضيٌّ، وصَفُّ “حكي”. مثال: مقالة معينة عن فنانٍ مُعَيَّنٍ، حاول أن تنزعَ اسم الفنان الأول من السياق، وضَعْ محلّهُ اسم فنان آخر، وستجد أن النص يناسب هذا الفنان، مثلما يناسب ذاك.
باختصار، جوابي، هو: لا يوجد نقد، بل يوجد ابتذال. النقد، يحتاج إلى ثقافة عميقة، ودراية واسعة بتاريخ الفن، وعلاقته بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالنظريات الفنية والجمالية.
في العراق، على سبيل المثال، يوجد نقد، ونقاد، ومثقفين كبار، أمثال شاكر حسن آل سعيد وغيره الكثير. أيضاً، في مصر، وفي بلاد المغرب العربي، عموماً.
أقول لك أكثر من ذلك: الكثير من المواد التي كُتبت عن تجربتي لا تُسعِدني، أبداً.
ماذا عن معارضك؟
معرضٌ جماعيٌ مع أصدقائي “الحماصنة” في حمص، ثم معارض فردية متتالية، وفي 2016 أقمت معرضاً فردياً في باريس – صالة “كلود لومان”، وشاركت بآرت فير في باريس، أيضاً، ومعرضاً فردياً في ألمانيا – بريمن، قبل فترة. وحالياً، في صالة “بيت الأزرق، في دمشق، وربما في صالة “زوايا”، لاحقاً. وغيرها من المعارض والمشاركات.
كلمة أخيرة..
الفن صعبٌ، والحياة صعبةٌ، وعلى الفنان أن يتعامل مع الفن والحياة بذكاء، على حدٍّ سواء. ماذا أقول؟! الكلمة – فعلاً – تَعْجَز عن التعبير. هنا ما يُقال، وهناك ما لا يُقال. الكلمة مراوغة، والمعنى عميقٌ، ومضمرٌ، يحملنا معه دون أن نعرِف إلى أين؟!
حكاية ما انحكت




