سؤال الطائفية وجوابه.. الطوائف في لحظة التفكيك والتركيب/ عبد الله مكسور
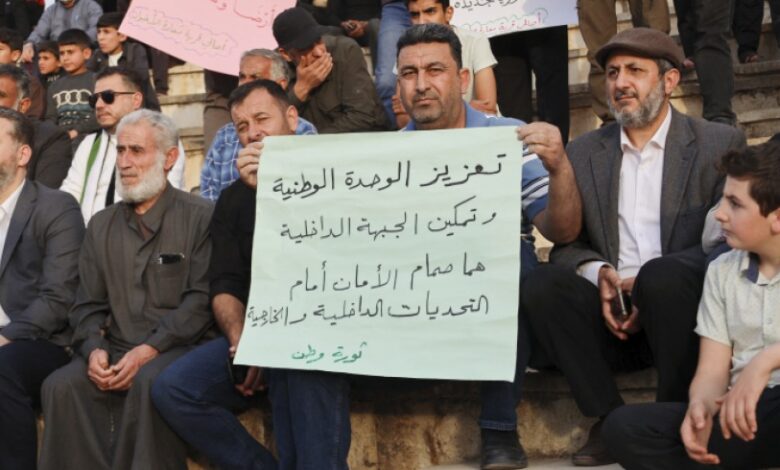
2025.05.08
في لحظات الانهيار الكبرى، تنبعث الأسئلة الأكثر حساسية من تحت ركام الدولة والمجتمع. وسؤال الطائفية في سوريا ليس عودة إلى جذور ضاربة في القدم بقدر ما هو سؤال مُلح في لحظة انفجارٍ في حاضر مفكك، باتت فيه “الطائفة” بقدر ما هي مرآة لهوية داخلية ضيقة فهي بشكل أو بآخر “مأوى الخوف”، لا تعبيراً عن الذات بل عن هشاشتها. والحالات التي نشهدها منذ سقوط نظام الأسد ليس طائفية كَمَنت طويلاً ثم ظهرت، وهي بطبيعة الحال لم تنمُ خلال الأيام الأولى للتحرير. بل طائفية بُنيت وصيغت “سواء من بيئات اجتماعية أو أدوات سياسية أو أجندات استعمارية” كأداة حديثة لإدارة الفقد: فقد الدولة، وفقد المعنى، وفقد الضمان. وبالتالي يغدو سؤال الطائفية ليس بوصفه مجرد انقسام ديني أو مذهبي، بل بوصفه بنية مصطنعة في مجموعة من الذهنيات لإعادة تشكيل الجماعة ذاتها تحت ضغط ما تعرِّفه تحت عنوان العنف والفقد، وكسياق يُعاد توظيفه خارج الحدود في إطار إقليمي ودولي بات يتعامل مع الكيانات الهشة كفرص استراتيجية واستثمارية لا كمشاريع إنقاذ.
إعادة إنتاج في لحظة الفقد
في سوريا ما بعد 8 ديسمبر 2024، لا يمكن فهم الطائفية بوصفها ارتداداً إلى “أصل”، ولا كتعبير عن هويةٍ مكبوتة ظهرت بمجرد انهيار نظام الأسد. إنها، بالأحرى، شكل من أشكال السعي لإعادة بناء الجماعة السياسية في غياب الدولة الجامعة، في لحظة انكشاف كامل، حيث يتقاطع الفقد الفردي مع الفقد العام، وحيث تُعاد صياغة “الطائفة” كضمانة حد أدنى للنجاة. وبهذا المنطق تحولت مناطق مثل جرمانا وصحنايا وأشرفيتها، حتى الساحل إلى مختبرات لإنتاج الطائفة خلال الأشهر الأولى من الانهيار كـ”خيال اجتماعي” وفق التعبيرات التي تنتهجها الفلسفة السياسية، ليُعاد تعريف الانتماء لا على أسس دينية أو مذهبية، بل بوصفه أداة للبقاء والدفاع في ذات الوقت. بمعنى الصورة المتخيلة للجماعة التي تمنح الفرد شعوراً بالأمان في فضاء متصدع. وبهذا صار الانتماء الطائفي أشبه بعقد أمان غير مكتوب، لا يحتاج إلى تديّن أو التزام شعائري، بل إلى اشتراك في شبكة الحماية: الحي، الكنيسة، الجامع، القائد المحلي، الحاجز، القافلة، المخزن، وكل ما قد يشكل مظلة جزئية وسط الغياب التام للسلطة المركزية أو ضعفها وعدم قدرتها على الاحتواء.
في تلك اللحظات، يصبح الانتماء الطائفي ليس تعبيراً عن عقيدة بل عن موقع في شبكة الحماية، كما لو أن سؤال “من أنت؟” يُجاب عليه بسؤال مخفي تحته: “من يحميك؟”. وهذا النوع من الطائفية لا يحمل صفة القداسة التي تخترق جماعة ما بشكل عمودي، نمت معها وكبرت في كل خطواتها التاريخية، إنها بشكل واضح أفقية أتت من عمق الانهيار وواكبته، وهي في جوهرها تعبير عن انهيار الفضاء العمومي لا عن صراع داخلي أصيل. لذلك يكون الذين ينظرون إلى تلك الدوائر من خارجها – على اختلاف طوائفهم- في حالة وفاق ولو بالحد الأدنى على الثوابت التي يختلف عليها من هم في داخل المواجهة الأفقية.
الطائفية كإعادة إنتاج للهوية في لحظة الفقد الوطني ليست مجرد ظاهرة اجتماعية يمكن فهمها بمعزل عن سياق الانهيار العام للدولة والهوية الوطنية، بل هي استجابة معقدة، بل وحتى مُركّبة، لانكشاف العُري الوجودي الذي يعيشه الأفراد حين تنهار البنى الجامعة التي كانت – ولو قسراً – تؤمّن الحد الأدنى من التعايش بين المكونات المختلفة. في سوريا ما بعد 8 ديسمبر 2024، ومع سقوط نظام الأسد، لم تعد الطائفية مجرد خطاب للسلطة أو أداة في يد النظام، بل تحولت إلى آلية دفاعية للنجاة، وجهاز إنتاج يومي للهوية الضيقة “الحصن” في مواجهة المجهول، حيث بات الفراغ السياسي يصنع المعنى بدل أن يحتويه أو يديره بالحد الأدنى.
وفي هذا السياق، ليست الطائفية في سوريا اليوم ارتداداً إلى “أصل” سحيق دفنته الدولة الحديثة، كما أنها – في تقديري- ليست تفجّراً تلقائياً لهوياتٍ دينية دفينة خرجت إلى السطح بمجرد انهيار الدولة. بل هي، في الحقيقة، تعبير عن لحظة اضطراب هائل، يُعاد فيها إنتاج الهوية الجماعية بوصفها وسيلة حماية لا بوصفها نظام معتقد. فالناس لا يعودون إلى الطائفة حبّاً بها، بل خوفاً من اللاشيء، من غياب القانون، من التفكك، من أن يصبحوا أهدافاً بلا مرجعية في فضاء أمني منفلت.
وهنا تُستعاد مقارنات تاريخية من تجارب بلدان أخرى –من منطقتنا وخارجها- واجهت انهيار الدولة وفقدان المعنى الجامع. في لبنان بعد الحرب الأهلية، أعيد إنتاج الطائفة كهوية ناجية، وليس فقط كهُوية قاتلة. حين فُقد الأمان العام، باتت كل طائفة تُنتج سرديتها وتبني اقتصادها، وتنشئ جيشها الصغير وإعلامها ومؤسساتها. وباتت تساؤلات الناس لا تبدأ بـ”ما هو الوطن؟” بل بـ”أين أعيش؟ من يحكم هنا؟ ومن يحميني؟”. وبالمثل، في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، تحولت الطوائف إلى وحدات سياسية/أمنية ذات سيادة فعلية، رغم أن الدولة الشكلية ما زالت قائمة. لكن الطائفة صارت عنواناً لإمكانية الحياة لا لمكانة روحية أو عقيدية.
في كل تلك السياقات، يظهر أن الطائفية ليست متجذرة في “التراث الضمني والعقلي بشكل واسع في سوريا”، بل هي صناعة حديثة، تنشأ حين تفشل الدولة الحديثة في أن تكون محايدة وضامنة للجميع. حيث لا يعود الإنسان مواطناً في دولة، بل عضواً في طائفة، لأن الطائفة – ولو جزئياً – تُعطيه مكاناً يمكن أن يموت فيه كإنسان ذي قيمة، لا كضحية بلا اسم.
وفي البوسنة بعد تفكك يوغوسلافيا، لم تكن الطائفة “الصرب، البوشناق، الكروات” مجرد هوية دينية أو قومية، بل تحولت في لحظة الانهيار إلى “بطاقة حياة”. لم يعد السؤال: من أنت؟ بل: إلى أي حاجر تنتمي؟ من يضمن أن تمرّ؟ كانت المساجد والكنائس تتحول إلى نقاط تجمع لا للصلاة، بل للنجاة أو للموت الجماعي في عباءة الطائفة. وفي ظل غياب الدولة، أعادت كل جماعة تعريف نفسها بوصفها دولة مصغّرة، لها حماة، وموتى، وقائمة خوف والأهم أساليب دفاعية وسياسية.
الطائفية أداة سلطة في الفراغ
إن سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، لم يكن فقط انهياراً لحكم سلطوي تقليدي، بل كان انهياراً لبنية السيطرة التي كانت تضبط المجال العام السوري لعقود. لم تكن الدولة، حتى في سنواتها الأخيرة، قادرة على منح العدالة أو الكرامة أوالخدمات بمعناها العام، لكنها احتفظت بحد أدنى من التماسك المؤسسي على بيروقراطيته. ذلك التماسك كان يوزع الخوف بالتساوي، ويحكم الناس بمزيج من القمع والتعويم، ويمنح الأفراد شعوراً – ولو زائفاً– بأن هناك “مرجعية عليا” تملك القرار. بعد سقوط النظام، سقط هذا الوهم. ومعه انهار العقد السياسي السوري القديم فلم يعد هناك مركز. وتحوّل الفراغ السياسي إلى ساحة لتصارع الجماعات من دون أفق واضح. في هذا الفراغ، برزت الطائفية لا بوصفها عقيدة دينية، بل كأداة لإعادة ترتيب السلطة والهيمنة والنجاة. من يسيطر على الحاجز؟، من يملك السلاح؟، من يوزع المساعدات؟، من يفاوض الخارج؟ لم تعد الإجابة مرتبطة بالدولة أو بممثلين منتخبين أو حتى زعامات تقليدية، بل باتت مشروطة بمنظومة فرعية – وموازية في بعض الأحيان – تعتمد على الطائفة كمصدر شرعية وحيد. الطائفية هنا ليست سردية قديمة أُعيد إحياؤها، بل هي نظام تشغيل سياسي جديد، يفرز الناس وفقاً لاصطفافاتهم، لا بالضرورة الدينية، بل الأمنية والمصلحية.
في الساحل السوري، الذي كان يُروّج له طويلاً كمجال “علوي”، ظهر التصدع بوضوح. انقسم العلويون بين خطوط الموالاة، وشبكات جديدة من أمراء الحرب، وأذرع أمنية منشقة، وأبناء الضباط الذين راكموا الثروة والسلطة خلال الحرب. لم يعد هناك رابط عصبوي موحّد. حتى داخل الجماعة الواحدة، برزت انقسامات طبقية وشبكية عميقة: من يملك السلاح؟ من يملك المفاتيح والصلات بالخارج رغم هروب كثير منهم إلى خارج الحدود السورية؟. وفي السويداء، انقسم الدروز إلى جماعات سياسية أومسلحة متنافسة، لا توحّدها الطائفة بل يفرّقها نوعية التحالفات. فالطائفة في الحالتين لم تعد مرآة لجماعة، بل أداة تَصنيف ضمن اقتصاد سياسي جديد يبحث عن النفوذ لا عن المعنى. والطائفي، في هذه المرحلة، وفقاً للفهم السابق، هو من يملك القدرة على الحماية لا الحقيقة. وبالتالي أصبحت الهوية المذهبية في كثير من الحالات نظام مرور اجتماعي يُحدد من ينجو ومن يُقصى، ومن يُمنح الشرعية ومن يُحرم منها. إنها لحظة يأس سياسي، تُستعاض فيها القوى المتحكمة على الجغرافية بالطائفة بوصفها “آخر الملاذات”.
يمكن مقارنة هذه الحالة بما جرى في العراق بعد سقوط نظام البعث العراقي عام 2003، حيث فُتح المجال السياسي بفراغٍ لا توازن فيه، وتحولت الطوائف إلى منصات للصراع على التمثيل والمغانم. نشأت حينها ما يُعرف بـ”الطائفية السياسية” التي توزع المناصب على أساس الانتماء المذهبي، لا الكفاءة أو المشروع الوطني. لكن الأخطر أن هذا التوزيع صار يفرض نفسه على المجتمع بكامله: من الحي الذي يعيش فيه المواطن العراقي إلى المدرسة التي يذهب إليها، إلى الوظيفة التي قد تُعرض عليه. الطائفة لم تعد خياراً، بل قدراً مفروضاً. وفي نموذج آخر أكثر دموية نراه في لبنان بعد الحرب الأهلية، حيث تحوّلت الطائفة إلى وسيط بين المواطن والدولة، فأُعيد تعريف المواطنة من خلال الطائفة، وصار الزعيم الطائفي هو الذي يوزع الحقوق ويحدد الواجبات وليس القانون. وهي نفس المعادلة التي تظهر اليوم في سوريا: الطائفة كـ”مزوّد خدمات” لا كإطار روحي، وكـ”حامٍ” بدل الدولة، وكـ”مرجع” بدل الدستور.
ما بعد الطائفية أم في ذروتها؟
تبعاً للمثالين السابقين فإن الطائفية ما بعد الديكتاتورية في سوريا، ليست عودة إلى الماضي، بل اختراع جديد لمستقبل هش، حيث تتشكل السلطات من بقايا العنف، ويُعاد بناء المجتمع على أسس لا تشبه ما كان عليه، بل على ما يمكن أن يضمن النجاة في حاضره القاسي. وهنا يأتي دور الدولة القوية التي تحمل واجب جمع الجميع واحتوائهم وضمان أمنهم، والأهم تجاوز المظلومية التاريخية إلى فضاء أكثر فهماً لمعنى كيف تقوم وتُبنى الدول.
الطائفية التي لم تكن يعترف بها النظام والمجتمع علنا في سوريا ما قبل سقوط نظام الأسد كانت عقلية سياسية تقوم على المصلحية في بنية النظام السياسي، دخلت القيمة الاجتماعية إليها بشكل معياري مرتبط بما تقدمه الجماعة للدولة ضمن شبكة المصالح الواسعة لسلطة الدولة، عكس العراق ولبنان، فالنظام البعثي في سوريا أسّس لفكرة “الدولة ما فوق الطوائف”، لكنه في الواقع أعاد إنتاجها تحت سطح الخطاب الرسمي، حيث باتت الطائفة مؤسسة غير مُعلنة للسلطة، وليست مجرد انتماء اجتماعي. هذا الكبت الطويل أنتج في لحظة الانهيار المدوي طائفية “مكبوتة”، خرجت بلا ضوابط، وبلا خطاب، وبلا مشروع. وهنا تصبح الطائفة لا مجرد ملاذ، بل سلاح في صراع على البقاء السياسي. إنها ليست عودة إلى ما قبل الدولة، بل قفزة إلى ما بعد الدولة، حيث يُعاد بناء السلطة على أسس مذهبية معلنة هذه المرة. يمكن لمس هذا الاتجاه بشكل واضح في خطوات السلطة الجديدة بمرحلة ما بعد السقوط المباشر عند الحديث عن اللون الواحد المنسجم المتفاهم في إدارة الملفات.
وهذا يقود إلى طرح فكرة إمكانية أن تكون سوريا الجديدة مختبرًا لنموذج جديد: يرفع شعار “ما بعد الطائفية”. لكن هذا يتطلب من السلطة التجريب بعيداً عن منطق اللون الواحد أو ما ينسجم معه، وإعادة بناء مفاصل الدولة ومؤسساتها على قواعد لا مذهبية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود فواعل داخلية وخارجية عابرة، والأهم أنها تستثمر في استمرار الانقسام. ولتأصيل ما سبق وتأطيره يمكن الرجوع لقراءة كتاب “الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة” الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للدكتور عزمي بشارة.
سؤال التاريخ والمستقبل
سؤال الطائفية في سوريا اليوم ليس سؤالاً عن التاريخ، بل عن المستقبل. عن قدرة مجتمعٍ ممزق على استعادة الدولة، لا بوصفها سلطة فقط، بل بوصفها فضاءً مشتركًا. الطوائف المتخيلة في العقول والواقع، والتي وُلدت من لحظة الانكشاف، لن تختفي بنهاية العنف، بل بافتتاح عهد جديد من التعاقد السياسي، يقوم على أرضية الثقة المتبادلة، ويعيد للمواطنة معناها، وللعدالة مركزيتها، وللهوية مرونتها. الطائفية ليست قدراً، لكنها قد تصبح كذلك إذا أُدير الانهيار بأدوات القسمة لا بأدوات الرؤية والتخطيط لمنع وقوعه.
سوريا، في لحظة ما بعد ديسمبر 2024، ليست فقط في امتحان إعادة البناء المادي، بل في امتحان إعادة تخيّل الذات الجمعية. فإما أن تكون الدولة مشروعًا جامعًا لما بعد الطوائف، أو أن تبقى الطوائف مشاريع مضادة للدولة تهدد وجودها في كل لحظة.
تلفزيون سوريا




