البدعة الأموية الجديدة في سوريا/ وسام سعادة
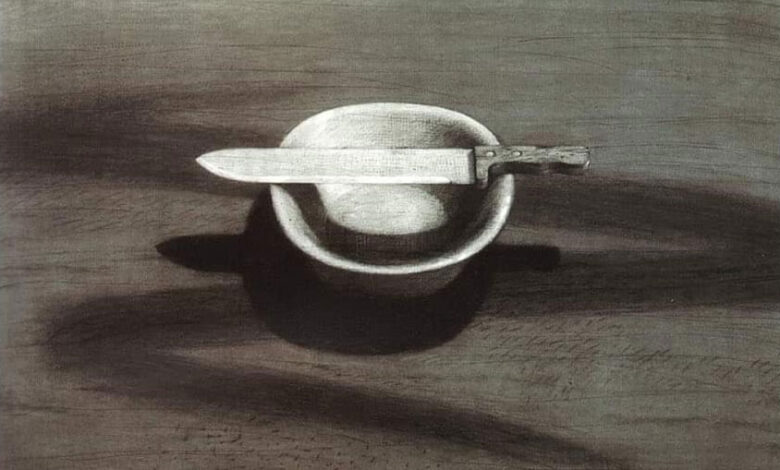
هل تستقيم الحالة “النيو ــــ أموية” في سوريا اليوم مع التاريخ الإسلامي ومع تعريف الجماعات الجهادية لنفسها؟ أم أنها حالة فانتازية لا أكثر؟ تقدم هذه المقالة رأيًا في هذا الشأن.
دخلت سوريا سريعًا في مناخ حرب أهلية طويلة الأمد، ومتعددة المنعطفات والمراحل. منذ أواخر العام 2011، تدهورت الحال على هذا النحو سريعًا بعد إيثار النظام الأسدي الرهان على القمع الدامي للاحتجاجات الواسعة ضده في معظم المدن المتوسطة من البلاد، والتي أخذت شكلًا أكثر محدودية في “العاصمتين” دمشق وحلب.
راهن النظام على “الحتمية الانشطارية” للقوى والأفكار التي اجتمعت ضده. فالهتافات من أجل الحرية والكرامة ما كان لها أن تعالج الصدع بين فئة تعتبر “الديموقراطية” شركًا يحاكم بغير ما أنزل الله من شرائع، وبين فئة تنظر إلى النظام بوصفه ديكتاتورية مقيتة، وبالتالي تجد الدعوة إلى التحوّل الديموقراطي منطقية.
كانت هناك شعبية لافتة لإبراز وحدة السوريين ضد النظام في المرحلة الأولى من تألق الاحتجاجات وشجاعة ناسها. إلا أن التوفيق بين هذه الرغبة الوحدوية الوطنية، وبين الإقرار بواقع التعددية الدينية والاثنية والمناطقية وكيفية صوغ مقاربة توازن بين التعددية الهوياتية هذه وبين التعددية السياسية وشروط مأسستها، كل هذا لم يجد سبيله إلى نقاش جدي، وصريح، في أي يوم.
كان الأمر أهون لو أن الثورة خرجت من المساجد فقط. في الواقع، خرجت الثورة من المساجد، إنما بقوالب مستعادة من “حزب البعث”. أطبق الوعي الهجين والشقي، البعثو ــــ إسلامو ــــ ليبرالي على نخب هذه الثورة، وسريعًا ما أدركت هذه النخب أيضًا أنها أساسًا بين خيارين؛ إما أن تشبك مع الميليشيات ذات النفحة السلفية والجهادية التي أخذت تتصدر المشهد في مواجهة النظام، وفي مواجهة بعضها البعض في آن، وعلى حساب الظواهر المدنية التي أخذت تنخسف أو تغادر البلاد، أو أنها ستعلَق في شرنقة الكلام عن مشروعية ثورة تشبه الشهرين الأولين فيها، أي لا تشبه الواقع الممتد والمرير الذي صارت معه الثورة نفسها بُعدًا من أبعاد الحرب الأهلية.
لم تكن هذه الحرب الأهلية متوازية، بل وليدة عجز النظام عن إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل خروج الاحتجاجات الواسعة ضده، وقدرته في الوقت نفسه على التعجيل بالتشوّه الكبير في المشهد، انطلاقًا مما عالق في هذا المشهد من تناقضات ومكابرات منذ البدء.
كانت وليد “التوازن الكارثي”، بتعبير غرامشي، وقد عنى القيادي والمفكر الشيوعي الإيطالي بذلك وضعًا تتوازن فيه القوى المتصارعة دون أن يتمكن أي منها من تحويل غلبة ما إلى هيمنة أو إلى حسم، ما يؤدي إلى حالة من الجمود والتلف.
كان هناك توازن كارثي في سوريا، من حيث أن لا النظام استطاع إنهاء الواقع المتمرّد ضده والمتفلت منه، لا بل أخذ يستثمر في هذا الواقع، ولا الثورة استطاعت إسقاط النظام، لا بل أخذت تتشبه بما تكون عليه “الثورات المضادة” في العادة، وذلك من خلال شيوع مفهوم الإمارة الميليشياوية السلفية ــــ الجهادية القائمة على خلطات رهيبة من الطاعة للأمير والمشورة بين المجاهدين.
ولم يكن هذا التوازن الكارثي “متوازنًا” في الوقت نفسه. إذ كان هناك من يمسك بأجهزة النظام ومرافق الدولة، ويشدّد على أنه يجسد مفهوم “الدولة”، بالدرجة نفسها الذي يجر فيها هذا المفهوم إلى حرب مع أنسجة المجتمع نفسه.
أضف إلى ذلك التدخل الأجنبي، الإيراني ثم الروسي، إلى جانب النظام، والذي كان أكثر قدرة على ترجيح كفة النظام في منعطف 2016 ــــ 2018 في مقابل تدفق عشرات آلاف الجهاديين القادمين من أنحاء مختلفة من دار الإسلام، من آسيا الوسطى حتى شمال أفريقيا، والذين استقطبتهم أساسًا كل من تجربتي، التنظيم المنشق عن قيادة أيمن الظواهري لتنظيم “القاعدة”، أي “داعش”، ثم التنظيم المستمر في الولاء للظواهري، وصولًا إلى لحظة تقبّل الظواهري نفسه فكّ العلاقة التنظيمية معه حرصًا على إعطائه حظوظًا أوفر في النطاق السوري، أي “جبهة النصرة”، أو تنظيم القاعدة المتحوّر، والذي تتمثّل كل إشكالية تحوّره منذ 2015 إلى اليوم في كيفية أن يكون “تنظيمًا سلفيًا جهاديًا في بلد واحد”، على طريقة النقاشات في عشرينيات الاتحاد السوفياتي بين “الاشتراكية في بلد واحد” وبين الرهان على تصدير الثورة.
بمعنى آخر، كان الأمر يرتبط بكيف يأمن التنظيم شرّ الولايات المتحدة ويتجنب بالتالي مصير أبو مصعب الزرقاوي وأبو بكر البغدادي وأسامة بن لادن، وكيف يبني فرعًا لـ”القاعدة” قادرًا على المعاندة والبقاء، بل متطلعًا إلى حكم سوريا، وكيف يُقيم “تعايشًا سلميًا” مع أمم الكفر، ليتمكّن من اجتثاث الكفر والبدع في المجتمع، وفرض المجانسة الإثنو ــــ مذهبية عليها بالتي هي أحسن. وان لم يحصل ذلك، فبحد السيف.
مشكلة الإسلاميين مع تاريخ المسلمين
اختار أمير “داعش” أبو بكر البغدادي إعلان نفسه خليفة “قرشيًا” على المسلمين في تموز/يوليو 2014 من محراب الجامع النوري الكبير بمدينة الموصل. لم يغب عن البال وقتها حجم الفارق بين السلطان نور الدين محمود زنكي (القرن السادس للهجرة، الثاني عشر للميلاد) الذي بُني الجامع الكبير في عهده، وبين البغدادي.
إذ يُفترض بنور الدين التركماني، من زاوية المنظار السلفي، أن يُحتسب على أهل البدع. فهو حنفي من جهة المذهب الفقهي، ماتريدي من جهة علم الكلام، وصوفي ــــ قادري مهتم بإنشاء “الخوانق”. لم يكن سهلًا التوفيق بين “التحنّن” على نموذج نور الدين زنكي كمقاتل للصليبيين وبين التبرّم من هذه الخلطة الحنفية التقليدية ــــ الكلامية الماتريدية ــــ الصوفية التي كان يمثلها.
في سياق تقويض حضور “داعش” في الموصل عام 2017، أُلحق بالجامع النوري دمار هائل، بمنارته الحدباء بالذات. وجرى تبادل الاتهام في حينه حول المتسبب بذلك ــــ “داعش” أو من قاتلوها ــــ وما إذا كان للتدمير خلفية مذهبية أم لا. كانت هذه اللحظة جزءًا من عملية تدمير واسعة النطاق للمخزون الأركيولوجي والحضاري لشعوب الهلال الخصيب منذ مطلع هذا القرن، أعادت طرح السؤال عن كيفية نظرة الإسلاميين عمومًا للتاريخ الاسلامي المديد.
من الناحية الشيعية، وبدلًا من النظرة الإيجابية لصنيع الأباطرة الصفويين، غلبت النظرة السلبية تجاههم. ومن الناحية السنية، لم يكن سهلًا أن تجتمع الحركات الإسلامية على نظرة مشتركة وجدّية للماضي السلطاني. فهذه الحركات مغتاظة من إلغاء مصطفى كمال عام 1924 الخلافة العثمانية. لكنّ النموذج العثماني للإمبراطورية لا يعجب الكثير منها، ولا النموذج السلجوقي، أو المملوكي، أو العباسي، أو الأموي.
ليس هذا تفصيلًا في الإسلاموية السنية. فهي قائمة في استعادتها لصفحات التاريخ على الانتقائية. اختيار عمر بن عبد العزيز فقط، دون سواه، من خلفاء بني أمية، والقادر بالله العباسي، دون سواه، من بني العباس.
نظرتها الإجمالية هي أن التاريخ الإسلامي لا ينفك ينحرف عن الإسلام الصحيح منذ انتهاء عهد الصحابة، سوى في بعض الاستثناءات. التاريخ يتهاوى في الفظيع، في العودة إلى الجاهلية، سوى استثناءات “تجديدية” للعلاقة مع زمن الصحابة. نظرة تشاؤمية لتاريخ المسلمين، تشترك مع النظرة التنويرية النمطية التي راجت في عصر النهضة العربية أيضًا للتاريخ نفسه: “المسلمون ابتعدوا عن الإسلام الصحيح”، مع فارق أن الإسلاميين يعتبرونهم ابتعدوا عن عقائد ومسالك جيل الصحابة، أي عن الأخذ بالسنّن، في حين اعتبر التنويريون أنهم ابتعدوا عن بساطة الإسلام الأول، و”قيمه” القائمة على المساواتية والتسامح والتشاركية والنائية عن الوساوس والتخاريف.
وفي الحالتين، على اختلاف الفداحة بينهما، ثمة عدم قدرة على الوصل مع التاريخ المديد للمسلمين، لصالح الجنوح إلى لعبة تناقض “ميتافيزيقية” بين الإسلام كأقنوم، وبين تاريخ المسلمين كتاريخ لـ”اغترابهم” عن هذا الاسلام، مأخوذًا كسُنن، أو كقِيم.
من البعث الأموي
إلى بعث بني أمية
المفارقة أن الأيديولوجيا القومية العربية، تحديدًا بشكلها “البعثي”، عملت على الاحتفاء بالرسول كباعث للأمة العربية ورسالتها الكونية الخالدة، وبخالد ابن الوليد كقائد لحركة التحرر الوطني للقبائل العربية في زمانه بوجه الروم والفرس. كذلك فعلت مع صلاح الدين الأيوبي، الكردي. جعلته قوميًا عربيًا، دون أن تسأله رأيه.
بشكل عام أيضًا، نظرت الأيديولوجيا القومية العربية ــــ البعثية، إلى “الأمويين” بوصفهم أقرب إلى تمثل معنى “العروبة” من الهاشمية العباسية، ورأت في نهاية حكم بني أمية في الشام عام 750 م. طعنة للعروبة، وأن هذه العروبة تألّقت بعد ذلك أكثر في الأندلس الأموية.
في زمن حكم حافظ الأسد لسوريا لم يجر التخفف من هذه النظرة التعظيمية للأمويين، ولا في سنوات حكم بشار الأسد قبل اندلاع الثورة. والدراما التاريخية السورية كانت مثابرة على إعداد مسلسلات، سواء عن أمويي دمشق أو عن أمويي قرطبة. نال السوريون عمومًا جرعة ملحمية زائدة من التقريظ البعثي ــــ الأسدي لبني أمية. فهل من المنطقي أن يشعروا بالحرمان من الحنين للأمويين بعد ذلك؟
جزئيًا، نعم، حصل ذلك بسبب دخول الإيرانيين والمسلحين الشيعة العراقيين واللبنانيين على خط إنجاد هذا النظام، بشعارات “استئنافية” للصراع مع يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وأساسًا، يمكن القول إن التقريظ البعثي لبني أمية كان يهتم أكثر بالانتساب إلى الفرع “المرواني”، لا السفياني من تلك العائلة، أو ذلك الفخذ، من قريش.
لكنّ النظام لم يعتمد فقط على “الحرس الثوري” والميليشيات الشيعية، بل اعتمد أيضًا على مؤسسة دينية سنية بالكامل إلى جانبه. مؤسسة مائلة حتى إلى السلفية. فإذا ما قارنّا بين علماء الدين السنة الذين عملوا إلى جانب النظام السوري، وبين الثقافة الدينية الأزهرية، سنجد أن معظم هؤلاء كانوا على يمين الأزهر.
الكلام عن تقييد حرية الالتزام الديني في سوريا في زمن “البعث” فيه قدر من الفانتازيا عجيب. يبني على إسقاط مظاهر لجأت إليها ميليشيا رفعت الأسد في منتصف الثمانينيات على كامل الحقبة (أو، إذا ما عدنا أدراجنا الى الستينيات، بعض الحساسيات في زمن “البعث” اليساروي مع المناخات الدينية المحافظة، وهذا ما غاب بشكل كبير بعد إطباق حافظ الأسد على النظام).
غابت في زمن “البعث” الأسدي عن السوريين معظم الحريات العامة، ولم يكن وضع الحريات الخاصة أسهل. إنما لا التعليم الديني الرسمي كان ينضح بالرؤى التنويرية، ولا الالتزام الديني البحت كان تحت الخطر. مقارنة بسيطة مع النموذج التونسي أيام الحبيب بورقيبة وزين الدين بن علي تظهر الفارق الشاسع. لم تذهب تونس في أي يوم لاعتماد النموذج الأتاتوركي كما هو، لكنّها منعت الزيجات المتعددة، وحاولت تقييد المساحة المعطاة للحجاب. شيء من هذا ما كان في الوارد في سوريا “البعثية”.
مع ذلك، ما إن سقط نظام بشار الأسد، من بعد استشراء حالة التلف داخله، وتراجع قدرة الإيرانيين و”حزب الله” عن الدفاع عنه، وما إن ظهر أن الأسدية لن تكون قادرة على البقاء، لا في منطقة دمشق ولا في الساحل، بل أن الروس ضغطوا بهذا الاتجاه بعدما تدخّلوا في الأيام الأولى لتقدّم ميليشيات “إمارة أدلب” نحو حلب، ثم نحو حمص، ما إن حصل كل ذلك حتى ظهرت تقليعة “انبعاث زمن بني أمية” في الشام، كما لو أن البعثيين “قصّروا” مع هؤلاء الأمويين في شيء. كما لو أن “البعثية” هي من الأساس شيء غير الإطناب في “مناقب بني أمية”. وكما لو أن النظام كان يحجر بالفعل على الالتزام الديني للسوريين، في حين كان يحجر عليهم في كل شيء، إلا في هذا الالتزام. وهذا لعب دورًا في الأسلمة الزائدة للمجتمع، بشكل صار معه جزء كبير من هذا المجتمع يرى في النظام حالة متناقضة دينيًا معه، بدلًا من أن يرى فيه نظامًا حارب الحريات كلها، إلا حرية التمسك بالقراءة اللاتنويرية للفكر الديني.
هكذا، أخذت تنتشر كلمات المنشد الجهادي “ماجد الخالدي” ــــ أبو هاجر:
“بنو أُميّة أصلهم ذهب..
من إسمهم كسرى ارتعب..
في مدحهم تعجز الكتب..
تاريخي وجع راسك..
يا ما تعرف أساسك..
يا مجوسي إلْنَا المفخره..
لا تحاول تاخذ خيبره..
منه كان الجانب حيدره..”
انتشرت إذاك معزوفتان: مظلومية السنة، وعودة الروح الأموية لسوريا. تفكيك ذلك يبدأ بالعودة لصفحات التاريخ بالفعل، لتبيان أن أوّل شكل ظهر في تاريخ الإسلام عن “مظلومية السنة” كانت مظلوميتهم على يد بني أمية.
مظلومية السنّة كانت على يد بني أمية!
أطاح العبّاسيّون بحكم بني أميّة في دمشق قبل أن يبزغ مفهوم “أهل السنّة والجماعة”. احتاج هذا المفهوم لعملية تلاقح وتآلف طويلة الأمد بين مفهومي “السنّة” و”الجماعة”، وهو ما استغرق ثلاثة قرون من التاريخ العباسي، لا الأموي.
في العصر الأموي، اصطدم المفهومان أكثر مما اجتمعا. احتفى الأمويون بمفهوم “الجماعة”، وأسّسوا سردية حوله. قوامها تنازل الحسن بن علي لمعاوية ابن أبي سفيان عن الخلافة عام 41 للهجرة، 661 م، وانتهاءً بحقبة “الفتنة الكبرى” كما جرى توصيفها لاحقًا، لصالح “عام الجماعة”.
رعا الأمويون هذا التمييز بين “الجماعة” و”الفرق”. فإسلام “الجماعة” كان الخطاب الرائج في الشام، وإسلام “الفرق” المختلفة كان يغلب على حال الكوفة وسائر العراقين. أما اتخاذ سنن النبي وأحاديثه مرجعيةً تُقارَن بمرجعية القرآن وتقترن بها، فهذا لم يعرفه الأمويون بشكل منهجي، نسقي، بل اختص به خصمهم الألد، في نهاية القرن السابع للميلاد، الأول للهجرة؛ عبد الله بن الزبير بن العوام، الذي يُعد في التصانيف السنية اليوم من “صغار الصحابة”، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر.
قاد ابن الزبير الخلافة السنية الحجازية في مواجهة بني أمية. كانت حربًا بين “أهل الجماعة” ــــ بهذا المعنى، أي الأمويين ــــ وبين “أهل السنة”، أي الزبيريين. ولم يتردّد الأمويون في حروب تلك المرحلة في دك الكعبة في مكة بالمنجنيق، وقد قام ابن الزبير بهدمها بعدما أصابها الحريق والتلف جراء ذلك، وأعاد بناءها من جديد.
ثم لم يتردّد الأمويون في ختام حربهم الضروس مع ابن الزبير في قتله وعدد من الصحابة والتابعين. وتصفهم المدوّنة التراثية بأنهم قُتلوا وهم متعلّقون بأستار الكعبة. فصل الحجاج الرهيب رأس عبد الله عن بدنه، وأرسل الرأس إلى عبد الملك بن مروان، وصلب باقي البدن.
مظلومية الشيعة على يد بني أمية مرتبطة بالمتواتر حول نقض العهد مع الإمام الحسن والتخلّص منه بالسم، وقتل الإمام الحسين وعائلته ومن في موكبه. لكن كانت هناك مظلومية سنية أيضًا.
إذ قتل الأمويون حفيد أبي بكر الصديق، وأمام أمه أسماء، وفظّعوا بالجثة. هذا في حين تمكّنوا من “تحييد” أخيه عروة، الذي اشتهر بروايته الحديث عن خالته عائشة. هكذا، تحوّلت “أسماء” الثكلى على ولديها مصعب وعبد الله، إلى رمز لمظلومية “السنيّين” على يد الأمويين.
فقط بعد هزيمة الزبيريين، ومقتل كل من مصعب ابن الزبير في العراق، وعبد الله ابن الزبير في الحجاز، سيجري تصوير المسائل كما لو أنهم كانوا عصاة، في حين أنهم كانوا يقودون “دولتهم” ــــ التي سيطرت في سني ما صار يعرف لاحقًا بزمن “الفتنة الثانية” ــــ على أنحاء واسعة من شبه الجزيرة والعراق، وهدّدت السيطرة الأموية على بلاد الشام. “الفتنة الثانية” كانت بشكل أساسي “حربًا أهلية” بين “أهل السنة” (الزبيريين) و”أهل الجماعة” (الأمويين ــــ المروانيين).
كان الصحابي عبد الله ابن الزبير خليفة “أهل السنة”، لأنه كان أيضًا من رواة الحديث. رواه عن أبيه الزبير، وعن جده لأمه أبو بكر الصديق، وعن أمه أسماء، وخالته عائشة، وعن عمر وعثمان. وهذا كافٍ لإظهار عدم إمكانية مطابقة غريمه، عبد الملك بن مروان، لهذه المكانة. لكنّ عملية “تلحيم” المدوّنة التراثية “السنية” لاحقًا، جعلت عبد الملك أيضًا من رواة الحديث، بحيث بات يروي عن أبي هريرة، وعن أبي سعيد الخدري.
يبقى أن الأساس هنا كان إبراز “المُحيّد” عروة بن الزبير كراوٍ للحديث على حساب مرجعية أخيه الخليفة المقتول عبد الله “ابن أبيه”، بحسب أحد الأحاديث النبوية. ومع ذلك، لم ينقطع لمرحلة طويلة التقليد الذي يصنف عبد الله ابن الزبير كخامس أو سادس الخلفاء الراشدين، بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن.
التأليف الذي حصل لاحقًا بين مفهوم أهل الجماعة وأهل السنة، حكم على التظلّم للزبيريين بأن يأتي خافتًا، دون أن ينقطع تمامًا. لم تندثر بسرعة النظرة للخلافة الزبيرية على أنها استمرارية للخط الراشدي، في مقابل “الملك العضوض”، الكسروية ــــ الأموية.
أكسروية يا معاوية؟
العبارة المنسوبة إلى عمر ابن الخطاب “أكسروية يا معاوية؟” في استهجان مظاهر الأبهة والبذخ التي اعتمدها معاوية في دمشق، كانت جزءًا من البروبغندا “السنية ــــ الزبيرية” المتصدّية للأمويين بذريعة أنهم “كسرويّون”.
كان هذا قبل قرون طويلة من اختلاط الحابل بالنابل ألف خلطة، ونغدو في زمن تلعب فيه “النيو ــــ أموية” الفانتازية، على طريق الفرع المتحوّر من تنظيم “القاعدة” المسيطر على دمشق وحلب حتى هذه اللحظة، لعبة “الأموية” في مقابل “كسرى والمجوس”. هذا بعد أن تحوّلت كلمة “مجوس” إلى شيفرة مذهبية استهدافية لجماعات دينية ثقافية بعينها. الشيعة الإمامية، والعلويون، والآن الدروز.
الانحياز ــــ في المرحلة العباسية ــــ لذكرى ابن الزبير، كان غالبًا على علماء مدرسة أهل الحديث والثبات، التي خرج منها أحمد بن حنبل. وقد استعاد في مسنده الأحاديث التي رواها الخليفة السني المقتول على يد الأمويين.
وفي حين أن خلفاء بني العباس أنفسهم انطلقوا من مظلومية الحسين، فقد ابتعدوا عن مفهوم “أهل البيت” لصالح مفهوم العشيرة، بني هاشم. هذا قبل أن يباشر الخلفاء العباسيون، بدءًا من المتوكل، عملية “تسنّنهم”، أي تقربهم من ابن حنبل وعلماء أهل الحديث. وزاد هذا الاتجاه التسنّني عند العباسيين مع استتباب الأمر في العراقين لصالح البويهيين، الشيعة الزيدييين، وهؤلاء أقاموا سلالة ملكية حاكمة دون إلغاء الخلافة العباسية، ولو أنهم حجّموها.
هذا عن الكسروية. أما عن “المجوسية” وتلبيسها لأقليات المنطقة، بدعوى أن الصراع هو بين “الأمويّة المنبعثة من جديد” (وهذه خلطة إسلاموــــ بعثية) وبين “حلف الأقليات” ظاهرًا كان أو مستترًا، فلها حكاية أخرى.
يبقى أنه ليس سهلًا أن تستعين بمقاتلين من آسيا الوسطى وتنادي على بني أمية، مثلما لم يكن سهلًا على البعثيين تلبيس صلاح الدين الأيوبي ثوبًا قوميًا عربيًا. وقد ذهب صدام حسين لأبعد من ذلك، وألبس هذا الثوب لحمورابي ونبوخذ نصر.
وليس سهلًا أن تكون سلفيًا جهاديًا، وتبحث في البدعة “النيو اسلامو ــــ أموية” عن ضالة للتوفيق بين رغبتك في فرض المجانسة الإثنوــــإسلاموــــ مذهبية في سوريا، وبين رغبتك في أن تنال رضا المعادلات المسيطرة في الإقليم وفي العالم، الخاضعة بشكل أساسي لتوجيهات واشنطن.
أوان




