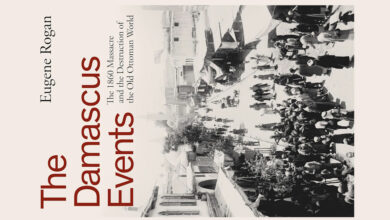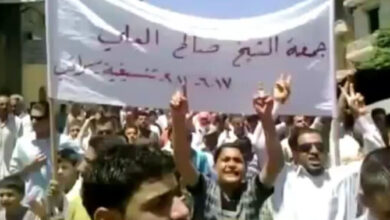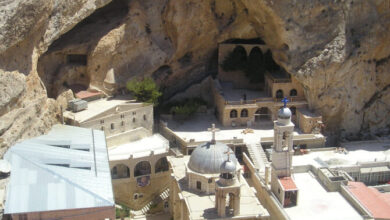تاريخ سوريا… من جديد/ كرم نشار

الوطن، أياً كان، ليس بحقيقة أزلية ومطلقة، بل منتج تاريخي تحكمه الظروف وتوازنات القوى والمصالح. كذلك فإن تشكل دولة ما –بما هو رسم للحدود وتأسيس لسلطة سياسية– قد لا يُلهب في صدور من يُفترض أنهم أبناؤها درجة متساوية من الحماسة والوطنية. البعض سيكون أقدر على التماهي مع الوطن الجديد، إما بسبب هيمنة ثقافية أو موقع مركزي أو فائدة اقتصادية، في حين يجد البعض الآخر نفسه في موقع هامشي يجعل من انتمائه الوطني أكثر غموضاً وتعقيداً. لذلك فإن مصير الأوطان يعتمد دائماً، وبالأخصّ خلال مراحل التشكل الأولى، على قدرة «أهل المركز» أو بعضهم على التشارك مع الآخرين سياسياً واقتصادياً وثقافياً، بما يضمن تعميم الخير والتأسيس لثقافة مواطنة حقيقية.
هذا الكلام قد يبدو بديهياً بالنسبة للكثيرين، لكنه غاب بلا شكّ عن المحتفين بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الجمعة الماضي، والتي تحدث فيها عن رغبة بعض النخب العلوية قبل زمن –ومنهم سليمان، الجدّ المباشر لبشار الأسد– في الإبقاء على الانتداب الفرنسي في سوريا. تعامل الكثير من جمهور الثورة مع الموضوع على أنه إثبات دامغ لخيانة متوارثة، في حين حاول البعض البحث عن أمثلة مضادة. لكن بقي غائباً الحديث عن السياق التاريخي الأعمّ الذي قد يبدو من خلاله طلب الحماية من المستعمِر أمراً قابلاً للفهم. وبالرغم من أن الواقعة نفسها مثبتة وموثقة منذ زمن في العديد من كتب التاريخ والسياسة، فقد جرى التعامل معها كـ«فضيحة» استثنائية ما كان ليعرف السوريين بها من دون الوزير فابيوس ومعرفته الواسعة بالأرشيف الفرنسي!!
لكن كم يعرف السوريون حقاً عن تاريخهم الحديث؟ وهل بدأوا بتحرير أنفسهم من الإرث الفكري لـ’حزب البعث‘ ولقراءته القومية للتاريخ؟ ثلاثة تحديات ترتبط بثلاث مراحل زمنية ستبرز على هذا الصعيد:
التحدي الأول يكمن في إعادة الاعتبار معرفياً للقرن السابق لظهور الدولة السورية الأولى تحت الحكم الفيصلي (قبل 1918). هناك، في العقود الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، تكمن جذور الطائفية السياسية الشعبية الحاضرة اليوم في الواقع السوري، والتي تختلف جذرياً عن الخلافات العقائدية الأكثر قِدَماً. على خلاف أقرانهم في لبنان، على سبيل المثال، لا يبدو السوريون من أبناء الطبقة الوسطى المتعلّمة معنيّين كثيراً بالعنف الطائفي الذي شهدته دمشق في تموز 1860، والذي راح ضحيته قرابة خمسة آلاف مسيحي. ربما اقتنعوا مع القوميين العرب بأن كل ما حدث كان نتيجة مؤامرة عثمانية-أوروبية، وربما آمنوا أن السبب هو «التخلف الحضاري»، لكن النتيجة في كلتا الحالتين هي هروب من التاريخ وتفويت لفرصة التعلم منه.
أحداث عام 1860 ستحضر مجدّداً في المرحلة التالية والتي بدأت مع الانتداب الفرنسي في عام 1919. لكن الفرق هنا كان في أن عملية التسييس الشعبي ستتجاوز وضع المسيحيين تحديداً لتشمل باقي الجماعات المكونة للوطن السوري الجديد. هنا يكمن التحدي الثاني، في النظر أبعد من القصة القائلة بتوافق وطني على النضال صفاً واحداً ضد الاستعمار… لا لأن القصة غير صحيحة، بل لأنها تؤسّس لنسيان كل الديناميات التاريخية المعاكسة لها. من الجيد بلا شك استعادة مواقف من قرّر في النهاية الاصطفاف خلف الهوية السورية، لكن من الضروري أيضاً معرفة التناقضات والمخاوف التي كان على هؤلاء تجاوزها أولاً. تهيّب الأقليات الطائفية من حكم سنّي متمركز في مدن الداخل لم يأتِ من فراغ، بل من ذاكرة جماعية لوقائع اضطهاد تكاد تكون مجهولة لمن هم خارج الطائفة. النقطة الأهم هي أنه حتى بدون اضطهاد سابق، فإن الدولة الحديثة بشكل عام تُخيف الجماعات المعزولة تاريخياً لأنها تفترض حضوراً أكبر للمركز في الحياة اليومية ونوعاً من توحيد الأعراف والقوانين.
مما لا شك فيه أيضاً أن هذه المخاوف لم تكن بمعزل عن السياق الدولي والاستعماري تحديداً، لكنها لم تكن من صنيعته أيضاً. وهي ستعود لتطفو على السطح بعد الاستقلال، وسط حكم برلماني ذي طابع ليبرالي محافظ وانقلابات عسكرية متلاحقة. التحدي الثالث، إعادة فهم هذه المرحلة، لا يتلخص فقط في تجاوز القراءة البعثية الخشبية لها، لكن أيضاً في عدم إنتاج النقيض الأيديولوجي تماماً. المطلوب هنا تجاوز ثنائية الشيطنة والتقديس للنظر في طبيعة العلاقة المعقدة التي ربطت أعيان المدن، الممثلين بـ’الحزب الوطني‘ و’حزب الشعب‘، بالأقليات وبأبناء الريف بشكل عام. وبعيداً عن البعد الطائفي والطبقي، تزخر سنوات الاستقلال الأولى بأسئلة هامة، مثل علاقة حلب الإشكالية مع باقي الوطن السوري نتيجة انفصال المدينة عن محيطها الحيوي الممتد من الموصل الى عنتاب وصولاً الى أنطاكية، أو علاقة الدولة مع الإسلام الممثل برجال الدين من جهة وبحركة ’الإخوان المسلمين‘ الناشئة من جهة. هذه أسئلة حيوية لمستقبل سوريا الديمقراطي، ونحن نكاد لا نعرف لها إجابات غير النزر اليسير.
يبقى القول إن جزءأً من تاريخ سوريا يشمل أيضاً صعود نخب شابّة منذ الثلاثينات، عزمت على الهروب من الواقع السوري الإشكالي نحو الأيديولوجيا. هكذا بات السوريون جميعاً بالنسبة لهؤلاء جزءاً من أمة عربية أو سورية أزلية، وبات الحديث في اختلافاتهم وتعدداتهم نوعاً من التجديف. التاريخ الاجتماعي والسياسي للمرحلة العثمانية تم تجاهله لصالح البحث عن الجذور القومية في عصور سابقة، والمرحلة الفرنسية تم تلخيصها بنضال موحّد ضد الاستعمار، ومرحلة الاستقلال بات عنوانها الرئيس الإقطاع والرجعية. الثورة اليوم تقتضي تفكيك هذا الإرث الأيديولوجي وإنتاج وعي تاريخي «مطابق». لا يعني هذا أبداً الانتقال من الايمان بالأمم للإيمان بطوائف مصمتة، ولا تقديس ما قد تمّ لفظه أو تشويهه، على العكس تماماً: ان قطيعة حقيقية مع الماضي لا تكون بدون معرفته حقاً، اما الوطنية الرومنسية والمؤدلجة فهي لا تمتّ لدولة المواطنة بصلة.
موقع الجمهورية