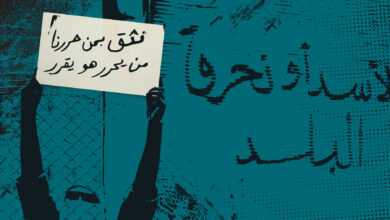أوقاف العلم السورية… يا للفرصة/ محمد أمير ناشر النعم

13 مايو 2025
كنّا طلاباً في المدرسة الخسروية منتصف الثمانينيات من القرن الماضي نأخذ راتبا شهريا من المدرسة مقداره 125 ليرة سورية مراعاة لشرط الواقف، وكنّا، نحن الطلاب، نتحدّث في ما بيننا بأنّ هذا الراتب لا يمثل إلا عشر ما نستحقه أو أقل من ذلك، وأنّ الدولة لو حافظت على أوقاف هذه المدرسة واستثمرتها استثماراً صحيحاً، ولو أنّها راعت شرط الواقف بدقة لأغنت الطلاب والمدرسين ولَعاشوا في رغد وغضارة، وكنّا نقرأ في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب للشيخ كامل الغزي عن وقفية هذه المدرسة وأوقافها: بساتين ومزارع وطواحين وإصطبلات ودكاكين وخانات في عينتاب وأنطاكية ومنبج وحارم وأعزار والجبول وجبل سمعان وحلب، ويكفي أن نعرف أنّ الخان الكبير الهائل خان الشونة الملاصق للمدرسة والمطل مباشرة على قلعة حلب كان من جملة أوقاف هذه المدرسة.
على مدار التاريخ الإسلامي لبّت مؤسسة الوقف الإسلامية الحاجات الروحية والمادية لأفراد المجتمع، وكان الوقف ثلاثة أنواع: الخيري الذي يخصِّص الواقف ممتلكاته لمؤسسة دينية أو مدنية خيرية. الذُّري (الأهلي) الذي يخصِّص صاحبه ممتلكاته لأبنائه وذريته، وعند انقراض السلالة تنتقل ملكية الموقوف إلى مؤسَّسة دينية أو مدنية خيرية يحدّدها الواقف، وكان من جملة أهداف هذا النوع من الوقف الحفاظ على الأراضي والعقارات من التقسيم والتجزئة إلى حصص صغيرة ومعقّدة يسهل استيلاء الحكّام أو الجشعين عليها، إذا قُسّمت وفق أنصبة الميراث. المشترك الذي يجمع بين الوقف الخيري والذري.
عدّد الشيخ مصطفى السباعي في كتابه من روائع حضارتنا قرابة 30 نوعاً من أنواع المؤسسات الخيرية التي أقامتها الأوقاف الإسلامية، كالمساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات والخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين والتكايا والزوايا، التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله، والسقايات، أي: تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعاً، والمطاعم الشعبية التي تقدّم الطعام للفقراء، وكانت حتى عهد قريب من القرن الماضي تُقدِّم ذلك في تكية السلطان سليم، وتكية الشيخ محيي الدين بن العربي، وحفر الآبار في الفَلَوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، وتمويل صناعة السلاح، ودعم الثغور في المناطق الحدودية التي تشهد مناوشات دائمة مع الجار العدو، وكانت بعض الأوقاف تُخصّص لتكون مقابر فيتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة وغيرها الكثير.
وتوسّعت دائرة اهتمام المؤسسات الوقفية لتشمل الحيوان، فكان هنالك أوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة، وأوقاف لرعي الحيوانات المسنّة العاجزة، ومن أوقاف دمشق وقف القطط تأكل منه وترعى وتنام، حتى لقد كان يجتمع في دارها المخصصة لها مئات القطط الفارهة السمينة التي يُقدّم لها الطعام كل يوم وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة والنزهة، وكذلك اشتُهر في حلب جامع ومدرسة العثمانية بوصفه مأوى للقطط المشرّدة، فكانت تلقى العناية ويُقدّم لها الطعام بانتظام. أما أطرف مؤسّسات الوقف الخيرية فوقف الأواني الذي خصصه أحد الأعيان في زمن المماليك للأولاد والخدم الذين يكسرون الأواني وهم في طريقهم للبيت، فيأتون إلى هذه المؤسسة، ليأخذوا أواني جديدة بدلاً من المكسورة، حتى لا ينالهم التعنيف أو يخالطهم الإحراج. كذلك نقرأ عن وقف النساء الغاضبات الذي كان يقدّم المأوى للمرأة التي تختلف مع زوجها، فيطلقها أو يهجرها، فتترك البيت وليس لها سكن تأوي إليه، فكان هذا الوقف يؤمّن لها المبيت والطعام والنفقة إلى أن تتزوج، أو تهدأ عاصفة الاختلاف بينها وبين زوجها، فترجع إلى منزل الزوجية.
ومنذ انهيار الدولة العثمانية ودخول سورية في مرحلة الاستعمار الفرنسي، ثم وغولها بعد عدة سنوات في مرحلة الاستعمار الأسدي كانت هنالك خطة ممنهجة غير معلنة، بقدر الوسع والطاقة، لتعطيل مؤسسة (الأوقاف)، وتفريغها من كل مضمون خيري، ومحاولة إبطائها إلى درجة الجمود، وإيقافها إلى حدّ الهمود.
وبدأت فكرة تقويض الأوقاف تقويضاً مقصوداً وواعياً منذ بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 حين أحبطت مؤسسة الأوقاف محاولات المستعمرين الفرنسيين شراء الأراضي الجزائرية مراراً وتكراراً، لأن أكثرها كانت أوقافاً إسلامية، ولذلك لم يكن من الممكن قانوناً نقل ملكياتها إلى هؤلاء المستعمرين، ومن أجل هذا السبب ومن أجل أسباب أخرى ليس هنا محل تفصيلها بدأ سعي الإدارة الاستعمارية للسيطرة على مؤسسة الوقف بسلسلة من التشريعات، وساعدها في ذلك مستشرقون فرنسيون شنّوا حملات لتشويه سمعة المؤسسة بين الجزائريين أنفسهم، ونحيل هنا إلى دراسة ديفيد باورز باللغة الإنكليزية: Orientalism, Colonialism, and Legal History: The Attack on MuslimFamily Endowments in Algeria and India.
انتقل هذا التأثير إلى سورية في عهد السياسة التغريبية للاستعمار الفرنسي، ويحدثنا فيليب خوري في كتابه سوريا والانتداب الفرنسي سياسة القومية العربية 1920 – 1945 قائلاً: “عانى الزعماء الدينيون المزيد من الإذلال على أيدي الفرنسيين الذين حاولوا كدولة مسيحية أن يفرضوا إشرافهم المباشر على مؤسسات دينية كالأوقاف التي غالباً ما كانت تقدّم جزءاً رئيسياً من مداخيلهم”، ويؤكد ذلك إدموند رباط في كتابه تطور سورية في ظل الانتداب عندما يناقش سياسات الانتداب الفرنسي في سورية، ومحاولات السيطرة على المؤسسات الدينية، مشيراً إلى أن الإدارة الفرنسية سعت إلى تقليص دور العلماء والمشايخ من خلال التحكم في مصادر تمويلهم، مثل الأوقاف.
أما الأثر الأبرز لهذه السياسة التغريبية فنراه في المرسومين التشريعيين رقم 76 و128 اللذين أصدرهما الانقلابي حسني الزعيم سنة 1949، ونُسبا إليه، وكان الأدق نسبتهما إلى وزير العدل أسعد الكوراني الذي كتب في مذكراته: “وكان إصدار هذه القوانين باقتراحي، وموضوعة من لجان كنت أرأسها فعلاً”.
كان هناك خلل بيّن في إدارة الأوقاف في تلك الآونة، ولكن بدلاً من الإصلاح كان الإلغاء والعلاج بالكي بل بالكرباج، فألغى المرسوم الأول الوقفين، الذُّري والمشترك، وأناط بمديرية الأوقاف العامة وفروعها في المحافظات إدارة عقارات هذه الأوقاف وبيعها واستثمارها. وأنهى المرسوم الثاني ولاية المتولّين على الأوقاف، وكلّف مديرية الأوقاف العامة إدارة الأوقاف الإسلامية على الصورة التي تحقق مصالح المسلمين من دون التقيّد بشرط الواقف ضارباً بذلك القاعدة الراسخة والصخرة الصلبة التي قام عليها بنيان الأوقاف الهائل: “شرط الواقف نصّ الشارع”، والتي تعني أن ما يوصي به صاحب الوقف له قوة التشريع، فهو صاحب الملك، وله وحده أن يقرّر في ما سينفق عائد ملكه. ثم توالت المراسيم الجائرة المتلاعبة المنتهكة في فترة حكم جمال عبد الناصر إبّان الوحدة مع مصر 1858 – 1961، ثم في فترة حكم الطغمة البعثية ثم الأسدية.
مائة سنة كاملة وهذه المؤسسة العظيمة في حالة موت بعد أن كانت إحدى أهم المحرّكات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية والتعليمية والدينية أصلاً وأساساً. وفي هذه الأثناء، وخلال هذه المائة سنة المنصرمة كانت الأمم الأخرى تطوّر أوقافها، وتستفيد منها استفادة تفوق كل تصوّر خلَّاق أو خيال مجنّح، وأقرب مثال لذلك أشهر الجامعات الأميركية التي نهضت وقامت واستمرت وتطوّرت من خلال الأوقاف، كجامعة هارفارد وييل وستانفورد وميشيغن وكولومبيا وماساتشوستس ونورث وسترن.
مقاربة تاريخية وواقعية من التجربة الألمانية
وكما أنّ الأوقاف الإسلامية في سورية تعرّضت للاستيلاء والتغوّل، فقد تعرّضت الأوقاف المسيحية في ألمانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى استيلاء الدولة الألمانية عليها، وعندما خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى مهزومة منكسرة أرادت أن تجمع شتاتها وتعيد بنيان نفسها بنياناً راسخاً، فأقامت جمهورية فايمار، وكتبت دستوراً حديثاً سنة 1919 لم تشهد ألمانيا في تاريخها مثيلاً له، واعتُبر وقتها من أفضل الدساتير في العالم. ألغى هذا الدستور نظام الكنيسة الحكومية الساري حتى ذلك الحين الذي كان بموجبه حاكم الدولة هو حامل السلطة الحكومية في كنيسة الدولة البروتستانتية، أي: لم تعد هناك كنيسة للدولة، وأكّد الدستور حرية الدين والضمير مستنداً في ذلك إلى فلسفة التنوير الكانطية والليبرالية القانونية، ولكنه لم يغفل عن تجاوز الحيف الذي وقع على ممتلكات الكنيسة، فقرّر تعويضها بما سمّي في الدستور نفسه بـ Staatsleistungen (معونات الدولة)، ضمن اتفاق أُبرم بين الدولة والكنيسة (البروتستانتية/ الكاثوليكية) تُقدّم الدولة بموجبه للكنيسة التزامات مالية سنوية تعويضاً عن عمليات المصادرة الكبرى التي حدثت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للعقارات والممتلكات التي كانت الكنائس تستخدمها في السابق، وتُقدَّم هذه المعونات تلبيةً لحاجات الكنيسة المادية وفقاً لتقدير الكنيسة نفسها، وليس وفقاً لتقدير الدولة، وقد أكّدت هذه الاتفاقات الدستورية المبرمة أنّ هذه المعونات ليست طوعية من الدولة، بل التزامات تاريخية لا يمكن إلغاؤها إلا في مقابل تعويض مناسب، ومنذ مائة سنة ونيف حتى اليوم ما زالت ألمانيا تدفع مبلغاً سنوياً هائلاً على سبيل التعويض، وهو في السنوات الأخيرة يفوق الـ 500 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى ما تقتطعه الكنيسة من ضريبة مالية من الدخل الشهري للمواطنين الألمان المنتسبين إليها: 8% في ولايتي بايرن وبادن ــ فورتمبيرغ، و9% في بقية الولايات البالغ عددها 14 ولاية، وبدءاً من سنة 2025 أُعفي مَنْ دخله أقل من 12 ألف يورو في السنة من هذه الضريبة.
وبهذه المعونات والضرائب، علاوةً على التبرعات ومساهمات الأفراد ومِنَح المؤسسات أُتيح للكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية أن تستمرا في تمويل أكبر جمعيتين أو منظمتين في البلاد: جمعية الدياكوني التابعة للكنيسة البروتستانتية، التي يعمل فيها 627349 موظفا، و700 ألف متطوع. وجمعية كاريتاس التابعة للكنيسة الكاثوليكية، التي يعمل فيها 729410 موظفين، ومئات آلاف المتطوعين. وهذه أرقام مهولة لموظفين يتبعون للمؤسسة الكنسية فقط يفوق عددهم، على سبيل المثال، كلّ الموظفين في دولة سورية البالغ عددهم قرابة المليون وربع المليون موظف.
واليوم نسمع أصواتاً ألمانية تنتقد هذه (المعونات)، وهنالك محاولات عديدة من معظم الأحزاب الألمانية: اليسار، البديل، الخضر، لتغيير هذا الواقع على مستوى البوندستاغ، ولكنها تُقابل بالرفض، كرفض اقتراح الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ سنة 2017 لإعادة “تقييم المعونات الحكومية للكنائس”، أو كرفض دعوة حزب الخضر في التحالف الحاكم سنة 2020 أيضًا إلى إنهاء هذه “التعويضات” التي تقدمها الدولة، وما زال الألمان يسوّغونها برؤية حقوقية تاريخية عمرها قرابة مائتي سنة، وباعتبار الفوائد التي تحصّلها الدولة والمجتمع من وراء هاتين الجمعيتين الضخمتين اللتين توظفان قرابة المليون وثلاثمائة وخمسين ألف موظف، وهذا العدد الكبير يتلاءم مع ما تقدمه مؤسساتها من خدمات إنسانية لا تضاهى، في مئات المدن والبلدات الألمانية، كالمشافي، ودور كبار السن، ومراكز الرعاية النهارية، ومكاتب خدمات الفئات الضعيفة وتحديداً اللاجئين.
وبناءً على ما سبق نتساءل: هل نشهد في سورية حين كتابة دستورها القادم ما يسمى Staatsleistungen (معونات الدولة)، ضمن اتفاق يبرم بين الدولة ووزارة الأوقاف تعويضاً عن الاستيلاء على الملكيات والريع والمنافع من الأوقاف الإسلامية؟.
تمكن الإشارة هنا إلى مثالين من آلاف الأمثلة. الأول: استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي منذ أكثر من 40 سنة على الأرض الوقفية التي بنى فوقها ما يشبه القلعة لتكون مقرّاً لفرع حزب البعث في أهم موقع في مدينة حلب مطلٍّ على الحديقة العامة، من دون أن يدفع قرشاً واحداً مقابل هذا الانتفاع والإشغال. فأين التعويض؟ وأين الإنصاف؟
أما المثال الثاني فالخبر الذي قرأناه عن اجتماع موسّع عقدته وزارة السياحة في الـ21 من الشهر الماضي (إبريل/ نيسان) لمناقشة تأهيل مجمع التكية السليمانية وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية ودينية تستقطب الزوّار. كلّ ما ورد في هذا اللقاء والاجتماع لا يراعي لا من قريب ولا من بعيد المهمّة الأساسية لهذا المكان، وهو جامع للصلاة، ومدرسة للعلم والتعليم، وتكية لمبيت الطلبة الغرباء، وحوانيت لخدمة الحجاج الذين ينزلون بساحة المكان، ولا يراعي كذلك شرط الواقف بأن يكون المكان في عهدة مفتي دمشق، كما يذكر الغزي في كتابه الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، ولذلك فإن العدل والإنصاف ههنا يقتضي أحد حلّين: الأول أن يعود هذا المكان إلى ما أُسّس عليه، أو أن يُدفع التعويض المناسب تماماً مثلما فعلت ألمانيا.
وما نقوله هنا ينسحب أيضاً على جميع المدارس المسيحية التي استولت عليها الدولة بعد سنة 1967، وضمتها إلى وزارة التربية، وقد أعاد بشار الأسد استثنائياً سنة 2020 ثانوية الأرض المقدسة في حلب إلى الآباء الفرنسيسكان الذين يتراوح عددهم ما بين العشرة إلى الخمسة عشر راهباً.
أخيراً: خليقٌ بسورية والسوريين اليوم أن يستعيدوا مؤسّسة الوقف التي عطّلها الكائدون والواهمون والمغفّلون، فحرموا السوريين من خيراتها الوفيرة، وإمكاناتها التطورية المدرارة، وخدماتها الهائلة التي لا يمكن حصرها في مقال.
نقرأ، منذ فترة، دائماً عن رجوع رأسماليين صناعيين سوريين إلى مختلف المحافظات السورية. ما أحراهم وهم يبادرون إلى إعادة العمل والإعمار أن يفكروا في تفعيل هذه المؤسسة التي أُميتت على مدار قرن، وحُصرت في المسجد بينما كانت 14 قرناً تشمل مناحي الحياة كافة.
العربي الجديد