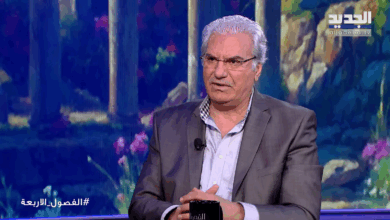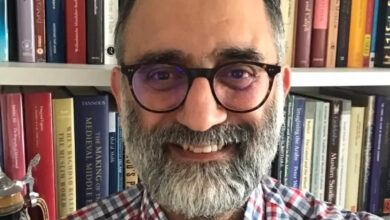حنين الصايغ: الحرية لا تأتي من دون مقابل

دارين حوماني
13 مايو 2025
في قلب كل امرأة من مجتمعاتنا العربية حكاية ترغب بقصّها على الملأ، وثمة حكايات يحق لها أن تُروى لأنها تطرح في رويها سكينًا يفكّك هذه المجتمعات في اختزالها للمرأة في كل شيء إلا نفسها والحقيقة. هكذا تطرح حنين الصايغ حكايتها، في نص إنساني متقن يطرح أسئلة عميقة حول المرأة والدين والمجتمع، وفي تداخل خاص وعام في عملها الروائي “ميثاق النساء” (دار الآداب، 2023)، وهو باكورتها الروائية بعد ثلاث مجموعات شعرية هي “منارات لتضليل الوقت”، “روح قديمة”، و”فليكن”. وتتناول الرواية رحلة البطلة أمل في سعيها للتحرر من قيود التقاليد والسلطة الأبوية في وسط المجتمع الدرزي في إحدى قرى لبنان.
تمكنت رواية “ميثاق النساء” من أن تحتل موقعًا في القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية (بوكر) في دورتها لعام 2025، وتُرجمت للألمانية. ويختصر المترجم الفنلندي سامبسا بلتونن تميّز الرواية وقدرتها على تقديم معالجة سردية محكمة خلال حفل الإعلان عن القائمة القصيرة، إذ يقول:
“‘ميثاق النساء‘ عمل سردي عميق يوازن بين الحميمية والتأمل. بأسلوب رشيق ومكثف تمزج الرواية بين البوح الشخصي والتحليل الاجتماعي من دون إصدار أحكام قاطعة ما يمنح شخصياتها بعدًا إنسانيًا يتجاوز التنميق”.
ويضيف:
“وصول الرواية إلى القائمة القصيرة يعود إلى قدرتها على تقديم معالجة ذكية لمفاهيم الانتماء والهوية والحرية والأمومة والكآبة والألم والأمل مع إبراز قوة السرد الداخلي والمونولوغي الذي يحوّل النص إلى مساحة من التساؤلات العميقة. ومن خلال سرد عميق بين السرد الروائي والنقد الاجتماعي تطرح الرواية تساؤلات جوهرية حول مصير المرأة في بيئات مقيدة مما يجلعها عملًا أدبيًا مؤثرًا تجاوز كونه شهادة عن الواقع إلى نص سردي محكم يستحق الالتفات إليه”.
عن روايتها وأعمالها الشعرية كان لنا هذا الحوار معها.
(*) “ميثاق النساء” هو عنوان أحد رسائل كتاب الحكمة، والذي كان له تأثير كبير على طريقة عيش الفتيات في المجتمع الدرزي، هل أثره فيك هو الذي دفعك لاختيار هذا العنوان؟
كلُّ دينٍ يبدأ كصرخةٍ مدوية في وجه الظلم، كثورةٍ تنبع من جوف المقهورين بحثًا عن عدالةٍ غائبة وكرامةٍ مُهانة. لكنه، ومع مرور الزمن، يتحوّل إلى منظومةٍ من القوانين الصارمة والعادات الموروثة. تُشيَّد حول الدين أسوارٌ من الطقوس والانضباط والتخويف، حتى ينسى أتباعه – ومعهم رجال الدين – جوهر الرسالة الأولى، ويغدو شاغلهم الأكبر ليس تخفيف المعاناة، بل مراقبة الناس، تقويم سلوكهم، محاسبة مشاعرهم، والتنقيب في أفكارهم. وفي كثيرٍ من الأديان، ومنها الدين الدرزي، تأخذ المرأة حيّزًا ضخمًا من هذا الانشغال: جسدها، ملابسها، زينتها، خصلات شعرها، نبرة صوتها… كلها تصبح موضوعًا للتنظيم والتأنيب، وكأن المرأة تحمل في ملامحها ومشاعرها خطيئةً مستترة يجب محاصرتها. وبما أنني ابنة هذا المجتمع الدرزي، وقد نشأت في كنف أسرة دينية محافظة، فقد تركت هذه التعاليم أثرًا عميقًا في حياتي، كما في حياة كثيرات من النساء حولي. من هذا الجرح، من هذا الفهم، وُلِد العنوان. كدعوة لكتابة ميثاقٍ موازٍ؛ ميثاق لم يُدوّنه رجل في كتاب، ولم تفرضه سلطة على المرأة، بل نشأ من التضامن، من الألم المشترك، من الإدراك الصامت بين النساء، حيث يتواصلن في بُعدٍ آخر، بُعد لا تقيّده حدود الدين ولا قوالب الثقافة ولا جغرافيا الانتماء.
(*) روايتك محمولة بنقد اجتماعي عميق، وإن كنت قد حدّدت فيها المجتمع الدرزي، إلا أنها تنطبق على المجتمعات الدينية الأخرى في لبنان، والتي يمكن اعتبارها منغلقة على نفسها، فهل تعرّضت لانتقادات باعتبار النقد موجّهًا لعادات مرتبطة بالطائفة قد تكون قاسية على الأفراد؟
كنت أعلم منذ البداية أني أناقش قضايا موجودة في كل الطوائف الدينية، لا في لبنان وحده، بل على امتداد العالم العربي. وحين صدرت الرواية، أدركت، من الرسائل والمراجعات التي وصلتني، أن قضايا النساء تتشابه رغم اختلاف السياقات: الألم واحد، والقلق واحد، وإن تنوعت الأزياء واللهجات. نعم، وُجهت إليّ انتقادات أنكرت واقع المرأة الدرزية كما قدمته، وأظن أنني لو كتبت عن طائفة أخرى، لقوبلت بردودٍ مشابهة. لكن ما فاجأني وأسعدني، كانت الرسائل التي وصلتني من نساء درزيات متدينات، عبّرن فيها عن امتنانهن، لأنني لامست معاناتهن من دون تعميم أو تشويه، وأظهرت صلابتهن من دون تزييف أو ادّعاء.
(*) تقولين في روايتك “لقد علّمني الخوف أن أكتم صوتي. كانت صفقة أبرمتها بمفردي مع الحياة كي أعيش بسلام. وهكذا تخليت عن صوتي على أقساط، عراكًا تلو آخر، صمتًا تلو آخر. اخترت السلام الذي يشبه الموت”، هناك خوف متتال في الرواية، من الأب، من الزوج، من دخول النار… الخوف بوصفه أداة إخضاع… هل الخوف يصنع الطاعة أو ادّعاء السلام الذي تحدثتِ عنه أم يقتل الذات؟
الخوف، حين يتمكن من القلب، لا يكتفي بإخماد الثقة بالنفس، بل يهدم أيضًا جسور الثقة بالآخرين، فيصبح التواصل بين أفراد العائلة حقلًا من الألغام، والخوض فيه مغامرة تُخشى عواقبها. والخوف يخلق صمتًا، والصمت يؤدي إلى عزلة موحشة يلوذ بها الإنسان هربًا من نظرات الآخرين، من أحكامهم، من توقّع الخيبة مع كل محاولة للتواصل. لكن هذا الصمت لا يصنع سلامًا، بل يبني عالمًا هشًا، يسوده النفاق، وتُسيّره الريبة، وتغيب عنه الألفة الحقيقية. أما الغضب الذي يولّده الكبت والخوف من العقاب، فلا يزول بالطاعة، بل ينكفئ إلى الداخل، يتحوّل إلى سمٍ بطيء يدمر الذات، كما حدث مع خلدون ونيرمين في الرواية. ذلك السلام الظاهري الذي يفرزه الخوف، ليس سوى نسخة منزلية من الخضوع الجماعي الذي تفرضه الديكتاتوريات على شعوبها: طاعةٌ شكلية تخفي تحتها آبارًا من العنف المكبوت والطائفية المتربّصة. وحين تُرخى قبضة القامع، ينفجر كل شيء دفعة واحدة، كما شهدنا في أكثر من بلد عربي، حيث تحوّل الخوف المكظوم إلى فوضى لا تُلجم.
(*) نقرأ الرواية أولًا كسيرة ذاتية، ثم ندرك أنها أكثر من سيرة ذاتية، إنها سيرة جماعية مبنية على مخاوف نساء في مكان ما في هذا العالم، هل روايتك كانت صوتًا للّاتي لا صوت لهن؟ وهل تعتقدين أن استعادة الصوت ممكنة بعد كل هذا الخوف؟
تلقيت رسائل من نساء من مختلف البلدان والطوائف، درزيات وغير درزيات، وجدن في الرواية صدىً لأسئلتهن الحائرة: عن الأمومة والشعور بالذنب، عن صورة المرأة المشوهة عن نفسها، عن دينامية السلطة في الأسرة وهشاشة العلاقات، عن الحب المحاصر والانكسارات الصامتة.
أما عن استعادة الصوت، فهي تبدأ بالاعتراف. أن نكفّ عن الكذب على أنفسنا، وأن ندرك أن الصمت لا يُنقذ، بل يُخدّر.
لكن استعادة الصوت لها ثمن. والحرية لا تأتي من دون مقابل. على كل امرأة أن تسأل نفسها: هل أُفضّل رضى الآخرين، أم تحققي كإنسانة؟ القرار في يدها وحدها، وهي وحدها تتحمل تبعاته.
(*) “كنت أشعر بحزن شديد من كل شيء”، و”ظننت أن عملي الجديد سيساعدني في تحسين صورتي أمام نفسي أو سيجعلني أتحمل هذه النفس من غير أن أمطرها بعبارات التحقير والكره كل يوم” و”فكرة الانتحار أصبحت قريبة مني”، ثمة ما يشبهنا كثيرًا ونحن نكتب، هل هو ألمك الخاص في الرواية وشعرتِ بالتحرر أو التخفف أثناء أو بعد الكتابة؟ بمعنى آخر، ما مدى التجانس بينك وبين الراوية أمل؟
من بين كل شخصيات الرواية، أمل هي الأقرب لي. تحمل من هواجسي ما يكفي لتجعلها مرآة صادقة لأفكاري وآلامي. لكنها أيضًا تحمل صوت نساء كثيرات اقتربت من وجعهن وسمعت قصصهن. الرواية ليست سيرة فردية، بل سيرة جراح مشتركة. وكان لكتابتها أثر علاجي كبير. ساعدتني على تفكيك ذاتي، وعلى الإنصات إلى مناطق مظلمة في داخلي. كل من يعرف نفسه جيدًا، يعرف أن الحياة لا تمر بدون أن نجرح أو نُجرَح. تشخيص المرض هو أول الطريق نحو الشفاء، ومواجهة الذات هي أصعب المعارك.
حنين الصايغ تتوسط المرشحين للقائمة القصيرة لجائزة بوكر على هامش حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة (أبو ظبي، 24-4-2025)
(*) الرجل في الرواية يمارس دوره الذكوري من دون اكتراث بمشاعر النساء، من تعنيف الأب إلى الليلة الأولى للزواج، والليالي المتلاحقة، في مقابل المرأة المقيدة، هل المرأة في الرواية ضحية فقط، أم أنها تحاول (ولو داخليًا) مقاومة هذا القمع؟
الرواية لا تقدم نموذجًا واحدًا لا للرجل ولا للمرأة. فيها الذكوري العنيف، وفيها المُحب، وفيها الضحية. وفيها النساء اللاتي ينكسرن، واللاتي يتمردن، واللاتي يحفرن في جدار الصمت طريقًا نحو الضوء. لم أرد للنساء أن يكنَّ مجرد ضحايا، بل صانعات للحدث، بنضجهن، بتحايلهن أحيانًا، وبمقاومتهن الصامتة أو العلنية. نساء الرواية خلقن لأنفسهن مساحات خفية يمارسن فيها حياتهن كما يشأن، بعيدًا عن آليات القهر والوصاية. وفي هذه المساحات الخفية يحققن انتصاراتٍ ويتكبدن عناءاتٍ لا يعرف عنها أحدٌ أي شيء.
(*) ثمة قسوة في الرواية، الأب الذي يقول لابنته الراغبة بالطلاق “كرامة المرأة في بيتها مع زوجها”، قسوة الزوج الذي يريد زوجته كل ليلة في الفراش، قسوة الصوت الذي في داخل الراوية ولا يتوقف عن تحقيرها “أن أمارس الجنس مع شخص انتهيت للتوّ من إبرام صفقة معه”، برأيك، هل تتحول المرأة إلى أداة استمرار في قمع ذاتها، بعد أن تُربّى على الخضوع؟
حين نُحمّل المرأة وحدها عبء قمعها، نغض الطرف عن سلسلةٍ طويلة من الأيادي التي شاركت في تشكيل هذا القفص. تُربّى الفتاة منذ نعومة أظفارها على الحذر في حضرة الرجال، على الصمت إذا أُهينت، وعلى إنكار الذات كي يقال عنها أنها فاضلة. وحين تتزوج، تنتقل معها هذه البرمجة إلى بيتٍ جديد، فتكرر الطقوس القديمة: تصمت حين يجب أن تحتج، تبرر حين يليق بها الغضب، وتقبل الإهانة كي تنال القبول. لكن، رغم هذا كله، لا يليق بالمرأة أن تحبس نفسها في دور الضحية إلى الأبد. الضحية تبقى ضحية حين تعتنق ضعفها وتلوّح به، وحين تتحول إلى حارس على أبواب نساء أخريات يسعين إلى الحرية. من أقسى ما زرعته مجتمعاتنا في وعي النساء، أن ترى المرأة في نجاح امرأة أخرى تهديدًا، لا إلهامًا، وأن تستشعر في تمرد سواها إدانةً لسكوتها.
“السلام الظاهري الذي يفرزه الخوف، ليس سوى نسخة منزلية من الخضوع الجماعي الذي تفرضه الديكتاتوريات على شعوبها: طاعةٌ شكلية تخفي تحتها آبارًا من العنف المكبوت والطائفية المتربّصة. وحين تُرخى قبضة القامع، ينفجر كل شيء دفعة واحدة، كما شهدنا في أكثر من بلد عربي”
(*) وصلت الرواية للقائمة القصيرة لجائزة بوكر، وتم الاحتفاء بها في أكثر من بلد، ما الذي يعنيه لك هذا، وهل أثبتت روايتك التي تم الاحتفاء بها أن الرواية هي التي تصنع الجائزة وليست الجائزة التي تصنع الرواية؟
رغم إدراكي منذ البداية أنني قدمت نصًا ناضجًا وأصيلًا، فقد حرصتُ على إبقاء سقف توقّعاتي منخفضًا، لا لأنني شككت في جودة ما كتبت، بل لأنني أردت أن أظل قريبة من ذلك الفرح البكر الذي لا تُفسده الحسابات. ولهذا كانت فرحتي كبيرة بوصول الرواية للقائمة القصيرة. لقد تعلّمنا منذ الطفولة أن نبحث عن الاعتراف، أن نُنصت بشوقٍ إلى كلمة تقدير أو تربيتة خفيفة على الكتف تُخبرنا أننا فعلنا شيئًا ذا قيمة. لهذا، حين بلغني خبر وصول روايتي إلى القائمة القصيرة، شعرت بشيء من الفخر، فذلك لم يكن مجرد لحظة انتصار شخصي، بل اعتراف أدبي من لجنة متخصصة بأن “ميثاق النساء” عمل يستحق أن يُدرج بين أبرز ما كُتب هذا العام. لكنني في نفس اللحظة ذكرت نفسي أن الجوائز لا تصنع مشروعًا أدبيًا، وأني أكتب أولًا لنفسي ثم للقارئات والقراء الذين يجدون فيما أكتب صدى لهواجسهم، وأن عليَّ أن أظل وفية لميثاق الكتابة هذا.
(*) تكتبين في قصيدة لك من مجموعة “منارات لتضليل الوقت”: “مهلًا عليّ أيها الشعر/ لقد نضجت كثيرًا/ بإمكانك أن تنام داخل رأسي الآن”، هل نام الشعر قليلًا فيك بعد كل النجاح الذي شهدته الرواية ما قد يدفعك للتوجّه للرواية حصرًا؟
نعم ولا. الشعر أصبح أكثر خجلًا منذ بدأتُ أُصغي لنفسي عبر السرد، لكنه لم يغب. هو حاضر، بعمقه وإيقاعه، في ثنايا الرواية، كما سيكون في الرواية المقبلة التي تصدر قريبًا. واللافت أن من أثنوا على شعرية اللغة في الرواية، ربما لم يقرأوا دواويني الشعرية أصلًا، فجمهور الشعر محدود جدًا. لم تسرقني الرواية من الشعر، بل ابتكرت له وظيفة جديدة كوصف الطبيعة أو ضبط المونولوغ الداخلي أو رصد لحظات التوتر بين أبطال الرواية. لجأت للرواية ربما لأن السرد يهبني حرية أكبر في معالجة قضايا كثيرة، وقدرة على ضبط الزمن والنبرة، على عكس الشعر، الذي يأتي مباغتًا ويرحل من دون استئذان.
(*) تقيمين بين ألمانيا ولبنان، هل تشعرين أن الكتابة من الخارج – من مكان مختلف ثقافيًا وقيميًا – منحك أدوات سردية ورؤيوية لفهم الألم الذي نشأتِ فيه؟ أم أن المسافة صنعت قطيعة شعورية يصعب ردمها؟
الكتابة الروائية تحتاج إلى عينٍ ترى من الخارج وأخرى تنغمس في الداخل. والمسافة، حين تُدار بحكمة، لا تخلق قطيعة، بل تتيح التأمل، تمنح شيئًا من الأمان العاطفي الذي يسمح بالحفر في التربة بدون أن ننزف. في برلين، حين كتبت روايتي الثانية، شعرت بهذا التوازن: بين الحنين وبين الهدوء، بين الذاكرة وبين التحليل. المكان لم يكن قيدًا ولا خلاصًا، بل أداة من أدوات الفهم.
ضفة ثالثة