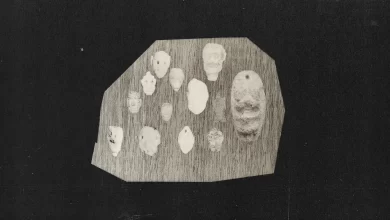ذئب البحر/ جولان حاجي

05/05/2025
شتاء 2018، زرتُ قبر بردراغ ماتفييفتش في مقبرة زغرب، بعدما لاحظتُ ما أقلقني في الساحة الرئيسية للمدينة. رأيتُ في المساء، أسفل تمثال الملك توميسلاف وحصانه، شموعاً مضاءة حول صورة لم أتذكّر عن صاحبها إلا مثوله أمام محكمة لاهاي متّهماً بجرائم حرب، فاستيقظتْ مخاوفي القديمة من الفاشية والرايات السوداء. هاتفتُ صديقة في روما لتتصل بميرا زوجة بردراغ ماتفييفيتش وترسل إليّ عنوان قبره. ذهبتُ في صباحٍ أبيض لأضع قرنفلة بيضاء عند رأسه. في ضوء الشمس ونور الثلج، بالكاد رأيتُ اسمه المحفور كالظّل الخافت على بياض الحجر.
الكاثوليك الطالبان
الكاتب الراحل ابن أمّ كرواتية وأب روسيّ. وُلد في بلدة موستار بالهرسك، على مبعدة خمسين كيلومتراً من البحر الأدرياتيكي. ظلّ يقدّم نفسه “يوغسلافياً” بعد تفكّك البلاد. لم يفارقه ولع الطفولة بالأنهار والسواحل، ولا أسئلتها البسيطة: لماذا تختلف الأغنيات والمآكل من ساحل لآخر؟ كيف لنا أنْ نقرأ نهراً أو بحراً؟ المتبحّر في حضارات شعوب المتوسط، صاحب “تراتيل متوسّطية”، الضليع في شجر الزيتون ومؤلّف الكتاب الفريد عن تاريخ الخبز، ركب كالفلاحين باخرة السلام التي جابت بـ “كبار الكتّاب” حوض المتوسط. انتبه جمال الغيطاني إلى “تواضعه”، وسمّاه كلاوديو ماغريس: “مستكشف الغياب”. لم يوفّر ماتفييفتش مناسبة لينتقد المتمسّكين بالأديان والقوميات، المعتدّين بنقاء الأصول والمرتدّين إليها في مرجل البلقان الدامي، حتى أنه نحت اصطلاح “الكاثوليك الطالبان”، لأن الأصوليين وعشّاق الرصاص والذبح بالسكّين موجودون في كلّ الديانات. الهراطقة الذين يستحقّون الموت على كلّ الجبهات. كان مقتنعاً بأنّ الاستفزاز ضروريّ للجميع، ليعترف كلّ شعب بالشرور التي ارتكبها بحقّ غيره. إلى متى سيتعامى “الوطنيون” عن الجرائم التي اقترفوها؟ متى يكفّون عن التشهير بجرائم أعدائهم وحدها؟ ولكن ما أكثر الذين تخوّفوا من إبداء رأيهم علناً، لأن القادة الجدد، كالقادة القدامى، عبدة القوّة.
نفاد الديناميت
ما جدوى أنْ ترفع مرآةً أمام كل ذلك الدم ليرى المجرمون أنفسهم، ومعهم المثقّفون الذين ساندوهم باليد واللسان؟ لم يوفّر المتطرّفون الكروات جهداً لطمس ما يستطيعون من السمات العثمانية في عمارة مدنهم وقراهم. دمّروا مساجد وقصفوا مآذن، وكتبوا على الأنقاض: “لا مكان للهراطقة”. قُتِلتْ وتشرّدتْ عائلاتٌ بأكملها في كوسوفو والبوسنة والهرسك، لأنها مسلمة، ثم قيل إنهم يقتلون أنفسهم بأيديهم ليلفتوا أنظار العالم إليهم، حُوصِروا ليلفتوا أنظار العالم إليهم، حتى تبدّدتْ أوهامهم بأنّ أوروبا ستخرج من لامبالاتها وتهبّ لنجدتهم، حتى أحرقوا كتب مكتباتهم الشخصية وأشجار حدائقهم المنزلية ليدفأوا.
كم من الكتّاب والفنّانين، في نهاية تلك الحرب الأهلية أو منذ بدايتها، اعترفوا بأنّهم توهّموا المقدرة على التأثير في مجرى الأحداث؟ “الله أعلم بما جرى” أفدحُ تلخيص لتلك الدوّامة. لا خلاصةَ لعذاب الإنسان. كانت لغة المجرمين هجيناً من البلاغة الستالينية التليدة ورطانة القوميّين ووعيد الكهنة، يتعذّر فيها التمييز بين الجناة والضحايا أو تسميتهم. سمة الحروب الحديثة أنّ معظم ضحاياها يسقطون كأضرار جانبية. الصرب الأرثوذوكس قصفوا كنائس الكروات الكاثوليك، وعصابات من كلا الشعبين تناوبوا على التنكيل بالمسلمين البوشناق في البوسنة والهرسك. صار البوسنيّون كلُّهم، في الإعلام الصربي على الخصوص، “تهديداً إسلامياً في قلب أوروبا المسيحية”. ثمة بيوت نجت، لسبب وحيد هو نفاد الديناميت باهظ الثمن. كانت تطفو في ضباب ذاكرتي صور مبهمة التفاصيل غطّت تلك المذابح، رأيتها في الصحف الورقية منذ عشرين أو خمسة وعشرين عاماً. كنتُ قد ذقتُ علقم المتفاخرين بدينهم قبل زيارة البلقان، فقد أرتني حلب أيضاً السباقَ البشع على العلوّ بين بُناة برج الكنيسة وبُناةِ مئذنة الجامع، أما الجبال في مدن البلقان البحرية فأعادتني إلى الجبال السورية في اللاذقية وأنطاكية، حيث تتشابه الأشجار والصخور بين المتوسّط والأدرياتيكي، لكنّ التاريخ لعن، ولا يزال يلعن، جمال تلك الجبال بالموت. أفكّر بمقتلة العلويين المدنيين، ربيع هذه السنة، في صنوبر جبلة التي يمرّ تحت جسرها نهر الصنوبر، ذاهباً إلى شرق المتوسّط.
الحنين إلى البحر
بانتهاء حرب البلقان سنة 2001، وصلتْ قوات الأمم المتحدّة بخوذها الزرقاء لتحفظ السلام في قلب حربٍ انتهتْ، ولم تتوقّف تماماً. أوشك المعلم بردراغ يهجر الجلوس في المقاهي، إذِ اقترب منه أحد المؤمنين الذين لم ينسوا تلك “الإهانة اللفظية الجمعية”: “نحن كاثوليك طالبان؟!” وبصق عليه لأنّه شبّه المتحضّرين بالهمج. لقّبوه: “ذئب البحر المسلم”. لامه بعض أصحابه على “مغالاته في انتقاد أهله الكروات في الهرسك”، وقاضاه زملاؤه “الكتّاب الوطنيّون” في محكمة زغرب. كان الإنسانيون عرضة لأعنف السخريات، لأنهم خونة تخلّوا عن إخوتهم، واضعين الإنسانية فوق أهلهم ودين أهلهم.
شتاء 2018، في تلك الرحلة نفسها، اخترنا، الروائية الفلسطينية عدنية شبلي وأنا، الذهاب إلى مدينة فوكوفار الحدودية بين صربيا وكرواتيا. مازَحَنا الروائيُّ السوريّ خالد خليفة: “أنتما تحبّان النكد”، لأنه المحبّ للسهرات اختار الذهاب إلى مدينة دوبروفنيك، المدينة السياحية التي سكنها توماس برنهارد (الهجّاء اللقيط الرهيب، الهارب من النازيين المتنكّرين في النمسا).
أردتُ أنْ أرى الناس في فوكوفار التي بدأت منها حرب البلقان الإثنية-الدينية في آب 1991 ودمّرتها بالقصف والحصار والمذابح. بعض أطلالها لا تزال قائمة: حاووز الماء المقصوف، وبنايات على طراز المعمار السوفييتي مثقّبة بالرصاص والقذائف. قالوا إنهم قد أبقوها للذكرى، كأنّ هناك حقاً مَن سيتّعظ، فيما كلُّ شيء حولك يذكّرك بما تريد أنْ تنساه. كانت كرواتيا على عتبة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وثمة مطار قريب من هذه المدينة تحمل طائراته الكروات الفقراء والمفلسين عمّالاً إلى ألمانيا وإيرلندا. في يوم صقيعيّ مشمس، مشينا حتى الدانوب. كانت كاسحات الجليد تعبر النهر الشاسع، مخيف الجمال، ذاهبة إلى أوسييك. في المياه العميقة للدانوب، ذاك “الحنين الهائل إلى البحر” (مصبه البحر الأسود لا البحر الأبيض)، رمتْ شرطة بلغراد جثثَ الرضّع والفتيات الألبانيات. بين الأشجار، على الضفة المقابلة، نُصبتِ المدافعُ الأولى التي قصفت الضفة التي كنّا واقفين عليها. قال لنا صاحب المقهى إنّ “القهوة التركية” اختفتْ من المقاهي. أبناء القتلة وأبناء القتلى يتجنّبون بعضهم البعض في المدارس والأماكن العامّة. لمعان عيونهم يشي بتعرّفهم المبكّر إلى أكبر المخاوف. كيف سيُمحى كل هذا القلق من النظرات؟ مع الأسف، مرور الأيام لا يمحو الذكريات. ربما لا يزالون على ما عهدوا عليه آباءهم.
مجلة رمان