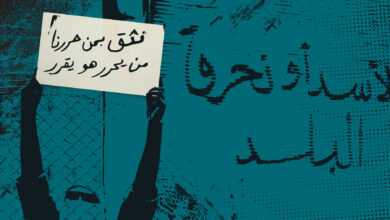سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 13 أيار 2025
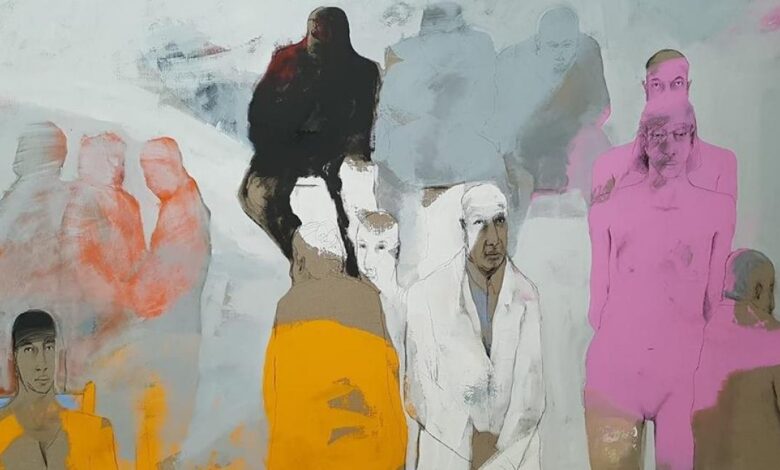
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————
الطريق الثالث.. الوطنية السورية ضرورة لا ترف!/ حسان الأسود
2025.05.11
“الوطن ليس ترابًا فحسب، بل هو ذاكرة وكرامة.” هكذا تكلّم ميخائيل نعيمة (17أكتوبر.1889- 28فبراير 1988)، وربّما يكون كلامه هذا وصفًا ملائمًا الآن لاسترجاع بعض التوازن لخطابنا السوري المتشنّج والموتور. فمنذ سنوات دخلنا في صراع ليس ضدّ النظام الدكتاتوري المقيم على صدورنا فحسب، بل وضدّ بعضنا فرادى وجماعات، وفي طريقنا سحقنا الوطن والهويّة والتاريخ إضافة للجغرافيا والديمغرافيا. نحن السوريين الواقفين على نبرة والموقدين النار تحت كلّ قدور الطبخ، إلا قِدْرِ طبختنا الوطنية التي ما زالت طبخة بحص، لم يعد يصدّق حتى الأطفال أنّها ستشبعهم وتملأ بطونهم الفارغة.
منذ قرن مضى، لم يكن لنا ترف اختيار طريقنا بحرّية نحو وطن يجسد طموحاتنا وهويتنا. والتاريخ هذا شهد محطات قاسية، تداخلت فيها عوامل الاستعمار والاستبداد، لتُغيّب أي فرصة لبناء دولة مستقلة ذات سيادة. كنّا فريسة ضعفنا الذي ورثناه عن الرجل المريض المنهار تحت ضربات الأقوياء، وكانت بلادنا في مركز زلزال التغييرات الدولية آنذاك، فلم يُسمح لنا باستكمال التجربة الأولى التي ابتدأت مع تشكيل المملكة العربية السورية إثر دخول قوات الشريف حسين دمشق. هكذا سرق الغرب من العرب، ومنّا نحن السوريين بالأخص، أوّل ديمقراطية، أو أوّل محاولة لبناء ديمقراطية على الأقل. هكذا حطّم أوّل تحالف بين الليبراليين والإسلاميين الساعين لبناء دولة مستقلّة ذات سيادة وديمقراطية في الوقت ذاته، وتقوم على جوهر أساسي هو اللامركزية. لقد كان الدستور المحطّم الذي أسقطه الانتداب الفرنسي أوّل وثيقة سورية، بل عربيّة، تؤسس لتشاركية قائمة على حكم لا مركزي يأخذ أوضاع أجزاء المملكة الدستورية آنذاك بعين الاعتبار، من فلسطين إلى الأردن إلى لبنان، التي كانت كلها جزءًا من المملكة السورية الوليدة. هكذا كتبت إليزابيث تومبسون، وسيكتب كثيرون غيرها لاحقًا.
واليوم، وبعد مضيّ قرنٍ ونيّف على ذلك التاريخ، وبعد أن صار الحفاظ على التقسيم الاستعماري هدفًا بذاته، لا لمحبتنا به، بل لخوفنا من تقسيم جديد أكثر حدّة ودموية وشرًّا، ووسط الانقسامات والتجاذبات والصراعات والتناحرات الكبيرة، وخاصّة ما يحصل في الساحل وريف حمص وحماة الغربي وما يحصل في جرمانا وصحنايا والسويداء، ووسط الغموض الذي يلفّ مصير مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تبدو الوطنية السورية أكثر من مجرد شعار؛ إنها ضرورة مصيرية للحفاظ على الإنسان قبل الأرض، فالأرض تبقى، وما يتغيّر هو الحدود السياسية التي تفرّق البشر أو تجمعهم. قد يجد كاتب هذه السطور مثلًا نفسه أقرب لابن الرمثا وإربد جغرافيًا واجتماعيًا ربّما من ابن دمشق أو حمص أو حلب أو إدلب، وهذا ليس تفضيلًا لهذا على أولئك، بل لأنّ الجغرافيا لها أحكامها التي لا تستطيع السياسة القفز عليها مهما تطاول الزمن.
بعد الثورة عام 2011 لم يطل الأمل كثيرًا، فسرعان ما تحولت الساحة السورية إلى مسرح لصراعات القوى الكبرى، مما أدى إلى تشظي الهوية الوطنية أكثر فأكثر. وبدلًا من تعزيز الوحدة، انكفأت الجماعات المختلفة إلى هويات فرعية طائفية وعرقية وحتى مناطقية. لكن هل نحن الوحيدين في العالم حتى نجرّب كل شيء ونبدأ دومًا من النقطة صفر؟ ألا يمكننا الاستفادة من تجارب ملهمة استطاعت فيها شعوب ممزقة أو مدمرة أن تُعيد تعريف نفسها وتبني هويات وطنية جامعة؟ الجواب نعم بكل تأكيد، ولنأخذ تجربتي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وجنوب أفريقيا بعد الأبارتايد بعجالة واختصار شديدين.
عقب هزيمتها الساحقة في الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا دولة مدمرة مادّيًا ومنهارة معنويًا. كان المجتمع الألماني متورطًا في واحدة من أكثر الأيديولوجيات عنفًا وتطرفًا في التاريخ الحديث، النازية. لكن التجربة الألمانية أظهرت كيف يمكن لشعب أن يُعيد بناء وطنه على أسس جديدة من الاعتراف والمساءلة والمصالحة. اعترف الألمان بداية بالواقع والجرائم التي ارتكبوها، وصحيح أنّهم خارجيًا نقلوا جزءًا كبيرًا من نتائج إحساسهم هذا بالذنب تجاه اليهود، وألقوه على عاتق العرب، عندما أسهموا بقوّة لا مثيل لها في بناء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، إلا أنّهم داخليًا رسخوا ثقافة الاعتراف بالذنب بعد أن حُوكم كبار مجرميهم النازيين في نورنبرغ. ثم أعادوا كتابة التاريخ القومي بعيدًا عن الأساطير العنصرية، وأعادوا بناء التعليم والإعلام وعززوا قيم الديمقراطية والعدالة. هكذا تمّ بناء هوية وطنية جامعة على أساس الدستور الجديد (Grundgesetz) الذي كرّس حقوق الإنسان والحرية والمواطنة المتساوية، ولم يعاندوا ويصرّوا على الإنكار أو التغاضي، بل تجرّأوا في مواجهة الحقيقة، والتأسيس على قيم جديدة.
أمّا جنوب أفريقيا التي خاض شعبها تجربة فريدة في تسعينيات القرن العشرين، فهي مثالٌ آخرٌ على إمكانية تجاوز الانقسام العرقي العميق من خلال مقاربة وطنية جامعة. بعد عقود من نظام الفصل العنصري، لم تلجأ جنوب أفريقيا إلى الانتقام، بل إلى العدالة الانتقالية من خلال لجنة الحقيقة والمصالحة التي رأسها الأسقف ديزموند توتو. فماذا فعلت هذه اللجنة؟ لقد اتبعت نهجًا واضحًا سار وفق خطوات مدروسة ليحقق الاعتراف العلني بالجرائم مقابل العفو، مما سمح بتفكيك البنية النفسية والعنفية للنظام السابق من دون حرب أهلية. وكان وجود القائد العظيم نيلسون مانديلا، فرصة لبناء قيادة وطنية استثنائية، شملت البيض والسود معًا. كرّس هذا كلّه عقدًا اجتماعيًا جديًا بُني على المساواة والعدالة وأعاد الثقة بين المكوّنات المختلفة للشعب، أو على الأقل أسس لتلك الثقة على أرضية راسخة وصلبة.
فماذا يمكننا أن نستفيد من هاتين التجربتين؟ يمكننا أن نتعلّم أن إعادة بناء الهوية الوطنية ممكنة حتى بعد الحرب والدمار، شرط أن تُبنى على الاعتراف والعدل والمشاركة وأن ندرك أنّ الثأر والتغاضي وجهان لعملة واحدة، الهروب من المساءلة لا يصنع وطنًا، كما أن الانتقام لا يبني عدالة. وأنّ القيادة التي ترفض الإقصاء وتؤمن بالحوار هي شرط لازم لأي مشروع وطني ناجح. “من لا يقرأ التاريخ يُجبر على تكراره.” أمام هذه اللوحة القاتمة، يبرز “الطريق الثالث” خيارًا لا بديل عنه، يتجاوز ثنائية الاستبداد العسكري والانغلاق الديني. هذا المشروع السوري الذي يجب أن يقوم على الحوار والانفتاح بين جميع المكونات من دون إقصاء، وعلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون. مشروع يرفض إعادة إنتاج الدكتاتورية بكل أشكالها (عسكرية، دينية، عائلية أو فردية). ويعيد تعريف الوطنية السورية كعقد اجتماعي طوعي يعترف بالتنوع ويُعزز المواطنة.
كما فعل الألمان، وكما فعل الجنوب أفريقيون، فإننا قادرون على صوغ هويتنا وبلدنا ودولتنا من جديد، لا على قاعدة النفي والإقصاء، بل على أساس الاعتراف المتبادل، والمشاركة الحقيقية، والعدالة الجامعة. ليست الوطنية السورية رفاهية يمكن تأجيلها، بل هي شرط البقاء ومعيار التحرر. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يُعيد بناء الإنسان والمجتمع والدولة على أسس العدالة والمساواة والحرية. وحده “الطريق الثالث”، طريق التشاركية والانفتاح، قادر على إخراج سوريا من نفق الاستبداد والانقسام، نحو دولة لجميع مواطنيها من دون استثن
تلفزيون سوريا
———————————–
عودة “منتدى الحوار السوري الديمقراطي”.. عين على الحريات وأمل بحوار بنّاء/ نينار خليفة
10 مايو 2025
بعد مرور نحو ربع قرن على إغلاقه، يعود “منتدى الحوار السوري الديمقراطي” ليفتح أبوابه من جديد، حاملًا معه آمالًا متجددة بإحياء الحياة السياسية في سوريا، وتعزيز مسارات النقاش الوطني حول القضايا الملحة، وفسح المجال أمام التعددية الفكرية والانخراط المجتمعي في صياغة مستقبل البلاد، وملامسة هموم الناس وآمالهم في التغيير الوطني المطلوب، ورسم ملامح سوريا الجديدة.
وخلال كلمته الافتتاحية عبر الداعية وعضو مجلس إدارة المنتدى، د. محمد العمار، عن أمله بأن يحمل قادم الأيام فرصة لبناء وطن “تحكمه قيمٌ جديدةٌ تقطع مع مملكة القمع، وتزهر فيه نبتة الحرية والديمقراطية، لتصبح شجرة باسقة يتفيأ ظلالها جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والحزبية والإثنية”.
وأمل أن يسهم المنتدى في “تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة الفعالة، وتحفيز النقاش العام حول قضايا العدالة والتنمية، وحقوق الإنسان، وتعزيز الاقتصاد، وتقديم حلول واقعية لخلق بيئة مثمرة للجميع”.
وفي ظل التحديات التي تمر بها سوريا اليوم، تأتي أهمية المنتديات السياسية من كونها منصات حيوية لتبادل الآراء، وصياغة الرؤى، وبناء جسور الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بدل الإقصاء والصراع والانقسام، والحرية السياسية في مواجهة القمع والتسلط.
إذ تعد الحريات العامة والتعددية السياسية من الركائز الأساسية لبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة والعدالة والشفافية. وفي ظل غياب هذه المبادئ عانت الحياة السياسية السورية على مدار أكثر من خمسة عقود حكمها نظام الأسدين، من الجمود والتهميش، حيث أغلقت مساحات التعبير الحر، وقمعت الأصوات المستقلة وقيدت المشاركة الشعبية تحت وطأة قبضة أمنية قل نظيرها.
وكان منتدى الحوار الوطني الذي أسسه السياسي ورجل الأعمال السوري، رياض سيف، في منزله بصحنايا مطلع الألفينات أحد أبرز ملامح فترة ربيع دمشق، التي بدأت مع تولي بشار الأسد مقاليد الحكم، واستمرت منذ منتصف تموز/ يوليو 2000 وحتى شباط/ فبراير 2001.
وقد شهدت تلك الفترة انفتاحًا سياسيًا سمح فيه بإنشاء منتديات حوارية تطالب بإصلاحات قضائية وقانونية واقتصادية، قبل أن تقابل بحملة قمع وإغلاق وسلسلة اعتقالات استهدفت عددًا من رموز هذا الحراك بينهم رياض الترك، ورياض سيف وحبيب عيسى وعارف دليلة. وقضى سيف حينها ست سنوات في السجن، وتم الحجز على أمواله ومنشآته الصناعية بعد فرض غرامات كيدية عليه، كما جرد من الحصانة البرلمانية.
كواليس الإطلاق
رئيسة المنتدى، الحقوقية والسياسية السورية جمانة سيف، تعتبر أن الفروقات بين الظروف المحيطة بعمل المنتدى مطلع الألفينات واليوم كبيرة جدًا.
وتقول في حديثها لـ”الترا سوريا”: “حاليًا تجري التحضيرات بمنتهى الحرية، لم تواجهنا أي تحديات أمنية أو مضايقات مشابهة لما واجهناه سابقًا، قمنا بكثير من الاجتماعات الثنائية والاستشارات مع ناشطين سابقين في فترة ربيع دمشق، ومع عدد من العائدين والمقيمين في البلد، حرصنا على التنوع باللجنة التي تدير المنتدى، كنا نأمل وما زلنا نعمل من أجل مشاركة نسائية أوسع”.
لكن صعوبات لوجستية أدت لتأخير انطلاقة المنتدى، تبين جمانة سيف: “كان المقر محتلًا من قبل ضابط أمن سابق استولى على المنزل بعد خروج والدي من سوريا وسكن فيه ثم أجره، وقد أخذ الموضوع وقتًا حتى خرج من كانوا يقطنون المنزل، وبدأنا بعمليات الإصلاح والترميم، التي احتاجت إلى الكثير من العمل حتى يكون المنزل جاهزًا للاستخدام كمنتدى، ثم تم تحضير الفرش وكل ما يلزم من إضاءة وأجهزة صوت”.
وحول هامش الحريات الذي تتيحه الإدارة الجديدة وطريقة تعاطيها مع إنشاء المنتدى، تقول سيف: “كنت قد وجهت دعوة لوزيرة الشؤون الاجتماعية، هند قبوات، التي استقبلتها بكل ترحاب وحضرت معنا الجلسة الأولى، أعتقد أن الحريات الموجودة حاليًا جيدة ونتمنى أن يتم توسيع مساحة المجتمع المدني والنشاط السياسي وتفعيل الحوار والمشاركة السياسية ليس على مستوى دمشق فقط، وإنما على كامل الجغرافيا السورية، يوجد أحيانًا بعض العقبات والتحديات لكنها تحل عندما تطالب الناس بحقوقها وتظل مصرة على حرياتها التي يضمنها أساسًا الإعلان الدستوري”.
اهتمام جماهيري لافت
انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان “السلم الأهلي والعدالة الانتقالية”، وتحدث فيها إلى جانب رياض سيف وجمانة سيف، الباحث في “المركز العربي بواشنطن” رضوان زيادة، والباحثة في قضايا المرأة خولة دنيا، وأدار الحوار الناطق الرسمي باسم المنتدى وعضو مجلس إدارته، معتصم السيوفي، وشهدت حضورًا مكثفًا من الناشطين السياسيين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام والصحافيين المحليين والأجانب.
ويعتبر معتصم السيوفي، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن الإقبال الكبير من قبل الحضور فاق التوقعات نظرًا لإرسال الدعوات قبل فترة قصيرة من الجلسة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تعطش السوريين ورغبتهم للحوار المدني الديمقراطي الذي يناقش قضايا عامة.
وينوه عضو مجلس إدارة المنتدى، الصحفي كمال شيخو، إلى أنه كان من اللافت تحمل العديد من المشاركين عناء السفر من محافظات دير الزور والحسكة وحلب والسويداء واللاذقية وغيرها، إلى جانب أن البعض منهم أجلوا مواعيد سفرهم ليتاح لهم المشاركة في الجلسة الافتتاحية.
ويضيف في حديثه لـ”الترا سوريا”: “نشرنا الدعوة على منصات المنتدى قبل خمسة أيام فقط، وتوقعنا أن تكون نسبة المشاركة محدودة نظرًا لضيق الوقت، لكن المفاجأة أن قاعة المنزل والحديقة وحتى مدخل البناء امتلأت بالضيوف، وقد جلس البعض على درج البناء وأرض الحديقة ليتاح لآخرين أخذ الكراسي”.
وسيعقد المنتدى جلسة حوارية شهرية، وأخرى موازية عندما تقتضي الضرورة لنقاش قضايا تهم السوريين، وفق ما يوضح كمال شيخو الذي يشير إلى أن المنتدى سيكون بمثابة فضاء مفتوح للحوار الجاد والمسؤول بين السوريين، وطرح مواضيع تمس الواقع كما هو، وتقديم الحلول والمقترحات ووجهات النظر حيالها.
ويرى شيخو أنه يجب أن يكون “جميع السوريين شركاء في هذا النشاط، ومسؤولين أمام التغيير ودفع الإدارة الجديدة لإفساح المجال لهذه الأنشطة التي ستصب في مصلحة بناء دولة قوية”.
آمال مرجوة
تؤكد رئيسة المنتدى، جمانة سيف، أهمية الحوار الجاد بين السوريين الذي تتيحه هكذا منتديات في الفترة الحالية، وأن تسمع كل وجهات النظر والتصورات مهما اختلفت وتعارضت، لتقريب وجهات النظر.
وتشرح في هذا السياق: “بعد أن بدأت الثورة وتحولت إلى نزاع مسلح وقسمت سوريا إلى عدة أجزاء كان يوجد انغلاق وحصار على كل منطقة نفوذ، وانقطع الحوار الشفاف بين السوريين، من الهام جدًا إعادة إطلاق هذا الحوار، وأن يسهم جميع السوريين برأيهم ورؤيتهم حول القضايا المطروحة التي تهمهم، وأن يشعروا بالمشاركة تجاه صياغة مستقبل بلدهم الجديد”.
وتضيف: “أرى أن الحوار يحل الكثير من التصورات المسبقة وسوء الفهم، ويساعد على التوصل لرؤى مشتركة وحلول لجميع القضايا الإشكالية التي تتنوع وجهات النظر حولها”.
بدوره يشير الناطق الرسمي باسم المنتدى، معتصم السيوفي، إلى أن تنشيط الحياة المدنية والسياسية أمر في غاية الأهمية، فقد قامت الثورة السورية من أجل الحريات السياسية وصون الكرامة ورفع الظلم.
ويلفت إلى أن هذه المنتديات تسهم في “تنشيط النقاش العام وخلق مساحات حوار تشعر المجتمع بالفاعلية بدل أن توكل الأمور فقط للسلطة الحالية في حل جميع المشاكل، وأن ترسى ثقافة حوار تتمثل بأن نجلس معًا في جو ديمقراطي محترم ونحاول الوصول لتصورات وحلول لمشاكلنا المشتركة على المستوى الوطني”.
ويأمل السيوفي أن يشارك في جلسات المنتدى سوريون من جميع الأطياف والأفكار وأن يشعروا أن بإمكانهم تبادل الآراء المختلفة دون الوصول إلى الخصام والمقاطعة، وأن يتم طرح قضايا لا يسلط الضوء عليها دائمًا، وتنشيط المبادرات المجتمعية المشتركة التي تناقش القضايا العامة.
بدورها تتطلع جمانة سيف إلى أن تتمخض عن جلسات المنتدى مخرجات توافقية يكون لها دور في تعزيز الفهم العام للسلم الأهلي والحياة المشتركة والحريات والديمقراطية، ونشر ثقافة احترام التنوع والاختلاف.
ملفات ملحة للنقاش
تشير جمانة سيف إلى وجود الكثير من الملفات التي يجب أن يتناقش حولها السوريون في المرحلة الحالية، أبرزها: “الوضع الاقتصادي وحلوله من وجهة نظر الخبراء، الانتقال السياسي وكيف يريد السوريون مستقبل بلدهم، وهذه قضية حساسة في ظل ما جرى أثناء الحوار الوطني الذي عقد ليوم واحد، والإعلان الدستوري الذي طاله الكثير من الملاحظات والتحفظات، ومن المهم جدًا النقاش حول الديمقراطية وضرورتها كحل وحيد من وجهة نظرنا لإدارة مجتمع سوري متنوع يشعر الجميع فيه أن حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم مصانة، ولا يزال مصطلح الديمقراطية غائبًا عن كل ما صدر من أوراق رسمية إلى الآن، قضية الحريات أيضًا من القضايا الأساسية التي ستطرح وتناقش في المنتدى”.
من جهته يرى معتصم السيوفي أن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي هي مسائل تأسيسية في الواقع السوري اليوم لأنها إذا لم تتحقق سينجر البلد نحو ظروف أصعب بكثير، إلى جانب أهمية الوضع الأمني وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، والوضع الاقتصادي والحوكمة والمؤسسات العامة، وخطوات الانتقال السياسي المتمثلة بالإعلان الدستوري، الحكومة، تنظيم هيئة العدالة الانتقالية، الانتخابات، الدستور الدائم للبلاد.
مستقبل مرهون بالحريات المتاحة
يعتبر معتصم السيوفي أننا نشهد اليوم انبعاثًا للعمل المدني والسياسي في سوريا، من خلال إنشاء المنتديات والجمعيات والتجمعات، لكن مستقبله مرهون باحترام السلطة الحالية لهذه الحريات الأساسية.
يقول: “على الحكومة استكمال عملية الحوار الوطني. أعتبر أن ما حدث جلسة أولى في مشوار، وعليها إصلاح الإعلان الدستوري لأنه يوجد فيه فجوات كبيرة، واستكمال خطوات الانتقال السياسي، واحترام الحريات العامة والخاصة مثل حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات”.
ويختتم حديثه بالقول: “المجتمع السوري مجتمع حي، عندما تتوفر الظروف المناسبة ينشط ويحاول أن يجد مساحات للتحرك والعمل العام وهذا أمر مهم جدًا، يبقى أن تحترم السلطة ذلك وأن تحميه وترعاه”.
الترا سوريا
———————–
انهيار اقتصاد الظل ومصير شبكة اقتصاد المخابرات السورية/ مهيب الرفاعي
الأحد 2025/05/11
بعد أكثر من خمسة عقود من حكم أمني قمعي غلَّف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا، انهار نظام الأسد وخلف وراءه تركةً ثقيلة للإدارة الجديدة؛ في بلد منهار تماماً يرزح 90 في المئة منه تحت خط الفقر. وبينما تتوجه الأنظار نحو بناء نظام سياسي واقتصادي جديد يساعد على إرساء قواعد لديمقراطية محلية في عهد الحكومة الجديدة، يغفل كثيرون عن تحدٍ لا يقل خطورة وتعقيداً عن التحديات الأمنية والعسكرية في البلاد وهو انهيار اقتصاد الأجهزة الأمنية الذي تغلغل في أعماق الاقتصاد السوري لعقود، والذي كان قد طوّر مجموعة شبكات لاقتصاد الظل.
شبكة مافيوية متجذّرة
لم تكن الأجهزة الأمنية السورية أدوات قمع سياسي وأمني فحسب، بل تحوّلت منذ السبعينيات إلى مراكز قوى اقتصادية مافيوية، تحت إمرة إدارات المخابرات السورية؛ وبالنتيجة نشأت شبكات مصالح اقتصادية عابرة للقطاعات والحدود، اعتمدت على القوة الأمنية والابتزاز لفرض سيطرتها على الموارد الوطنية والأسواق. بعد 2011، بدأ التغول الأمني لتشكيل امبراطورية اقتصادية للمسؤولين الأمنيين من خلال الحواجز العسكرية التي قطعت اوصال المدن وفرضت إتاوات على السيارات والمصالح التي تنتقل بين مدينة إلى أخرى، وأرهقت اقتصادها لا سيما القطاع الزراعي والصناعي في المنطقة الجنوبية من دمشق ومناطق حلب والمدينة الصناعية في حمص.
تباينت هذه الإتاوات بحسب البضائع المنقولة، وفُرضت وصاية أمنية على العديد من المصانع المحلية إما من خلال إجبار أصحاب المصالح على تنفيذ شراكات مع المسؤولين بحجة الحماية والدعم وإيجاد مخارج لقرارات حكومة نظام الأسد حينها؛ أو من خلال فرض حصة شهرية من الأرباح لصالح ما يسمى “الترفيق الأمني” عبر توفير سيارات حماية أمنية وعناصر مسلحين ترافق البضائع وتعبر الحواجز على “الخط العسكري” من خلال تفتيش شكلي؛ حيث استغل المسؤولون الفوضى الأمنية في البلاد لفرض مبالغ باهظة على رجال الأعمال، مقابل السماح لهم بالعمل أو حماية مصالحهم من الابتزاز والمصادرة. بالإضافة إلى مبادرات الترفيق الأمني، نشأت شبكات التهريب الداخلية والعابرة للحدود حيث كان هناك سيطرة شبه مطلقة على طرق تهريب المخدرات، كالحشيش والكبتاغون، والأسلحة، والسلع الأساسية عبر الحدود مع لبنان، والعراق، والأردن، حيث تشير تقديرات 2022 إلى أن صادرات الكبتاغون السورية بلغت نحو 5.7 مليار دولار سنوياً من وإلى لبنان والعراق والخليج العربي لصالح قوات الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع.
وعلى غرار الحماية الأمنية، تغولت المخابرات في سوق العقارات السوري، الذي شهد فورةَ في الأسعار نتيجة النزوح الإجباري من مناطق تركز عليها القصف والتدمير الوحشي، ووجود مستثمرين أجانب ابرزهم الإيرانيون و الروس لا سيما في الساحل ودمشق. كان التحكم بسوق العقارات عبر واجهات تجارية وسماسرة محسوبين على الأجهزة الأمنية، واستحوذ المسؤولون على عقارات حيوية في دمشق، واللاذقية وطرطوس، وحمص إما بالضغط الأمني او التهديد باعتقال ملاكها الأصليين أو حتى الاستيلاء عنوة وتحويل ملكياتها لمستثمرين أجانب مقابل الحصول على أموال أو امتيازات في الخارج. لزيادة التحكم في سوق العقارات، رافق هذا السلوك إجراء أمني هو الحصول على “موافقة أمنية” في حال أرد أي من المواطنين بيع أو نقل أو استئجار أي عقار (تجاري أو منزلي)، لمعرفة وضع المالك الأمني و يتم الإجراء بناء عليه. في حال كان صاحب العقار مطلوباً للأفرع الأمنية، لا يُسمح بالاستفادة من العقار، ويتجرأ مسؤولون أمنيون على العقار بحجة أنه لمعارضين أو سكان هاجروا بسبب وضعهم الأمني.
سمحت السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات السورية بالتغول في مساحات التجارة الداخلية، وأملى المسؤولون الأمنيون في كل قطاع تجاري شروطهم على حركة السلع والأسعار عبر احتكار تراخيص الاستيراد والتوزيع، وإجبار التجار على التعاون مع الدوريات الأمنية التي يسيرها قادة القطاعات، وتوظيف مجموعة مندوبين أمنيين إلى الأسواق الكبرى كسوق الهال وسوق الحمراء والصالحية في دمشق، وأسواق الفرقان والموكامبو وسيف الدولة في حلب وغيرها ؛ تقوم بدور الجباية لصالح قادات القطاعات. استباحت الأجهزة الأمنية هذه الأسواق لدرجة انها أصبحت قادرة على التلاعب بالقطاع المصرفي والسوق السوداء عبر شركات وهمية ورجال واجهة لنهب العملة الصعبة والتحكم بأسعار الصرف، فأصبح لدينا سعر وهمي وسعر السوق المركزي وسعر السوق السوداء، و يختلف السعر من محافظة إلى أخرى. هذا الاقتصاد “الموازي” لم يكن ثانوياً أو هامشياً؛ بل مثّل رافعة تمويل أساسية للنظام، وقاعدة ولاء لشبكة من الضباط ورجال الأعمال المرتبطين بالأجهزة الأمنية.
سقوط النظام وانهيار اقتصاد الأجهزة
مع تفكك أجهزة النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، انهارت تباعاً المنظومة التي كانت تحمي هذه الشبكات الاقتصادية. فقد فقدت تلك الشبكات الحماية القانونية والسياسية التي كانت تعفيها من المحاسبة والملاحقة؛ وشبكات الولاء الشخصي التي بُنيت على علاقات مع الأسد ودائرته الضيقة؛ وفقدت سيطرة الأجهزة على المنافذ الحدودية التي كانت تُدرّ مئات الملايين من تجارة السلاح والبشر والمخدرات.
نظرياً، الانهيار حميد وموفق لصالح الشعب المنهك اقتصادياً، لكن عملياً، يطرح هذا الانهيار مخاطر جدية على الاقتصاد والمجتمع السوري في الرحلة الانتقالية على أقل تقدير. كان نتيجة هذا الانهيار والاستخفاف بقوانين الإدارة الجديدة التي لم تُبدِ حزماً في تنفيذ عدالة انتقالية واضحة؛ نشوء شبكات جريمة منظمة مستقلة (أو ممولة)، تتكون من فلول نظام الأسد، قد تتحول إلى مجموعة أمراء حرب محليين يُعيدون تنظيم شبكات التهريب والجريمة و يتحكمون بمنافذ البلاد بشكل أو بآخر يعيد تعطيل الاقتصاد الرسمي في ظل استمرار الاقتصاد الموازي الذي يقوّض جهود بناء بيئة اقتصادية شرعية وشفافة. غياب هذه العدالة من جهة وعودة عناصر موالية لنظام الأسد كانت قد تبخرت ليلة السقوط مع عتادها في ظروف غامضة، يقود إلى تهديد الأمن الاجتماعي على اعتبار أن عشرات الآلاف ممن كانوا منتفعين من اقتصاد الأجهزة قد يجدون أنفسهم بلا مصادر دخل، الأمر الذي ينذر باضطرابات وحالات تمرد.
توجهات الإدارة الجديدة
القصة ليست اقتصاداً غير رسمي بسيط أو تجارة تهريب عابرة، بل شبكة اقتصاد أجهزة أمنية معقدة تمتد منذ عقود، تداخلت فيها المصالح الأمنية مع المال والسياسة، وتحولت أجهزة المخابرات إلى أدوات للسيطرة على الموارد، واحتكار الاقتصاد والأعمال. التعامل مع هذا الإرث لن يكون سهلاً، وهناك على الأقل ثلاث طرق يمكن التفكير بحالة سوريا المنهكة والمضطربة اقتصادياً؛ أولها عبر التفكيك القانوني الكامل، أي محاسبة الكبار ممن استفادوا ونهبوا، عبر هيئة عدالة انتقالية مستقلة تحاكم هؤلاء وتصادر أموالهم، بتعاون دولي لكشف الأرصدة والعقارات خارج سوريا؛ وثانيها الاستيعاب التدريجي، بمعنى أن تفاوض الدولة الجديدة مع العناصر الأقل نفوذاً ممن انخرطوا في اقتصاد الأجهزة، وتعرض عليهم تسوية أو عفواً محدوداً مقابل اندماجهم في الاقتصاد الرسمي وتخليهم عن الأنشطة غير المشروعة. هذا خيار عملي، وقد يجنّب البلاد صدامات عنيفة لكنه مخاطره تكمن في أن بعض الفساد سيُشرعن بشكل جديد، وقد يصعب لاحقاً ضبط هؤلاء بالكامل.
أما ثالثها، فهو هو بناء اقتصاد بديل مغرٍ، عبر إيجاد فرص أفضل داخل الاقتصاد من خلال إصلاح القوانين، وتشجيع المشاريع الصغيرة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وإعادة ضبط النظام المصرفي، بحيث يشعر السوريون أن العمل في الاقتصاد الرسمي أكثر أماناً وربحية من العودة لاقتصاد الظل. يحتاج هذا الحل تمويلاً ودعماً دولياً (وهذا ظاهر في الدعم الذي قدمته دولة قطر للحكومة السورية من خلال تقديم منحة مالية قيمتها 87 مليون دولار، موزعة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، أي بمعدل 29 مليون دولار شهرياً)، وبالتالي إن نجح هذا المسار فسيقلّص تلقائياً نفوذ الاقتصاد غير المشروع لصالح اقتصاد متكامل.
المدن
——————————————–
عن كرة السلّة وما بعدها/ سمر يزبك
13 مايو 2025
ليس في أن يمارس رئيس الجمهورية كرة السلّة ما يثير الإدانة في ذاته. من حقّ أي شعب، بمن فيهم السوريون، أن يروا رئيسهم على نحو غير تقليدي، إنساناً، لا تمثالاً، شخصاً يتحرّك ويتصبّب عرقاً، ويفرح، لا مجرّد صورة موضوعة في إطار رسمي. لا عيب في المشهد نفسه، لكنّ المشكلة ليست في المشهد، بل في السياق. فما بدا تمريناً رياضياً، كان في جوهره تمريناً بصرياً معدّاً بدقة، ضمن حملة علاقات عامّة موجّهة أساساً إلى الخارج. الخارج الذي ما زالت السلطة تسعى إلى إعادة التموضع ضمن خرائطه، والظهور أمامه بمظهر النظام القادر على تقديم “وجه مدني”. أمّا الداخل، فلا يعنيه هذا النوع من الإشارات. هو غارق في قضايا أكثر إلحاحاً: السلم الأهلي المهدد، آلاف العائلات تنتظر العدالة عن جرائم النظام السابق، وحدة وطنية هشّة، ضحايا جدد ينتظرون من الدولة الجديدة أن تمنحهم الأمان وتضمن مطالبهم بالعدالة عن المقتلة التي وقعت لهم ولمطالب غيرهم، وواقع اقتصادي لا يمنح أفقاً لأحد. في مثل هذا المناخ، تغدو الرموز باردة إن لم تسندها إجراءات واضحة، وإشارات حقيقية نحو التغيير. حين تخرج صورة الرئيس، مرتدياً بذلته الرسمية، ممسكاً بكرة سلّة داخل ملعب مغلق، ومحاطاً بفريق تصوير، في وقت تتسع فيه الفجوة بين السلطة والناس، يكون السؤال: لمن تُرسل هذه الصورة؟ إلى من تتوجّه؟ وما الذي تقوله في العمق؟ لا يعارض السوريون صورة رئيسٍ يمارس الرياضة. لكنهم يدركون أن الحياة، كما هي عندهم، لا تسمح باللعب أصلاً. هذا هو الفارق. لا تُستفزّ الصورة بذاتها، بل بفراغها السياسي. لا يُطلب من رأس الدولة أن يمتنع عن الظهور إنساناً، بل يُطلب منه ألا يتوقّف عند ذلك، وألا يعامل “الإنسانية” بديلاً عن الوظيفة الدستورية.
بدورها، كشفت زيارة الرئيس الأخيرة إلى فرنسا مجدّداً عمق الانقسام بين السوريين، حتى وهم في المنفى. في باريس، خرجت تظاهرتان، إحداهما مؤيّدة، تستقبل الشرع بصفته ممثّلاً للسيادة الوطنية، وأخرى معترضة، ترى في ظهوره إهانة لمظلومية لم تُعالَج. هذا الانقسام لا يُختصر في الشعار، بل يتجذّر في غياب أي صيغة جامعة لمفهوم “الوطن” نفسه. أي سورية نعني؟ ولمن هي هذه البلاد أصلاً؟ أسئلة لم تنجح السلطة حتى الآن في الإجابة عنها. في خضم هذا الفراغ، تصبح الرموز عبئاً إذا لم تُحمَل على مشروع وطني واضح. اللعب أمام الكاميرا لا يصنع سياسة، ولا يعيد توزيع الثقة، ولا يرمّم ما انكسر بين المواطن والدولة. وفي المقابل، لا يطلب المواطن المُستنزَف معجزة. يطلب فقط أن يشعر بأن المؤسّسات تعمل، وأن هناك قانوناً يُطبَّق، وأن الأمن لا يعني الصمت، ولا أن يكون لفئة من دون غيرها.
في نظام جمهوري، يُفترض أن الرئاسة ليست مساحة لمراكمة الكاريزما، بل موقعٌ لممارسة السلطة وفق توازنها المؤسّسي. والمشكلة في الصورة أنها تُضفي طابعاً شخصياً على ما يُفترض أن يكون تعبيراً عن الدولة، لا عن الفرد. الرئيس ليس نجماً، بل ضامناً لمسار عام. ومن دون هذا المعنى، تفقد الصور جدواها، مهما بدت ودّية. المصالحة بين المجتمع ودولته تبدأ من إعادة بناء الثقة على أسس واضحة: ضمان الحقوق، وتداول المعرفة، وحماية القانون، واحترام التنوع داخل الوطن الواحد. ولا تُحلّ أزمة سياسية عميقة باستبدال الجدّية بالمشهد، بل بإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والناس.
نعم، من حقّ السوريين أن يشاهدوا رئيساً يشبههم. من حقّهم أن يشعروا بأن من يحكمهم لا ينتمي إلى طبقة خارج الواقع. لكن قبل ذلك، هم بحاجة إلى من يعيد الواقع نفسه إلى مساره. من حقّهم جميعاً أن يشعروا بأن هذه البلاد بلادهم، من حقهم أن يذكّروا الجميع، بمن فيهم السلطة القائمة، أن الشعب خرج قبل عشر سنوات بمطلب: “الشعب السوري واحد” و”الشعب السوري ما بينذلّ”. لا بالكلمات، ولا بالصور، بل بإرادة فعلية لاستعادة ما تفتّت: وحدة السوريين والشعور الجمعي بأن هذه البلاد، رغم كلّ شيء، لا تزال ممكنة.
العربي الجديد
————————
السائل والمسؤول وما بينهما…/ سلام الكواكبي
11 مايو 2025
اعتاد السوريون والسوريات العاملون في الحقل الإعلامي، أو جرى تعويدهم بالعصا، عقوداً، على ألا يطرحوا في المؤتمرات الصحافية وفي اللقاءات الرسمية إلا أسئلةً تمليها عليهم الأجهزة المختصة في السلطة. لتتحول من ثَمّ هذه اللقاءات إلى جلسات استماع ولا استمتاع بما يهرف به المسؤولون والمسؤولات طوال ساعات من دون مناقشة، أو اعتراض، أو استفسار، أو انتقاد. ولقد وصل الحال إلى أن اعتبرنا القاعدة في الإصغاء وفي التجاوب وفي المحاباة وفي الثناء على الكلام ومديح المتكلم والابتعاد عن إحراجه ولو بلطافة مصطنعة. وفي أخفّ العواقب على تجاوز الصحافي الخط الأحمر المرسوم من أباطرة الاستبداد، فسيكون إقصاؤه عن الحضور في المناسبات المماثلة، وفي أشدّها عقاباً سيكون جهاز الأمن ساهراً بعين واحدة لكي يخفيه ويغمض عيونه إلى الأبد وما بعد الأبد. وامتد التعوّد إلى المتلقّي الذي اعتقد أن الهدف من المؤتمرات الصحافية مع من هم في القيادة أن تحصر نفسها في كيل المديح أو طرح أسئلة غوغائية لا لون لها ولا رائحة ولا طعم. وفي أخبث المواقف، يُطلب من الصحافي المدجّن أن يطرح سؤالاً محرجاً لطرفٍ محدّد في المنصّة مع إذابة أسئلته الموجّهة إلى أصحاب الأمر في مصيره في ماء فاترة حد الغثيان.
اليوم، يكتشف السوريون، من العامة وحتى من النخبة، المؤتمرات الصحافية التي يواجه خلالها الصحافي الرئيس أو المسؤول بما طاب له من أسئلة، وحيث يمكن له أن يبدي عدم رضاه عن الجواب أو عدم اكتفائه بما ورد على لسان المسؤول، ليعيد صياغة السؤال بطريقةٍ يفهم منها هذا المسؤول بأنه لم يُجب فعلاً عما طُرح عليه، ومن مسؤوليته إجابةُ الصحافي/ة. لقد اعتادا على الطاعة والتمجيد للحاكم بأمره إلى درجةٍ صار من يختلف عنهم في الأسلوب ومن له تجربة أخرى وفي أجواء مختلفة ربما تتمتع بهامشٍ ما من الحرّية في التعبير وفي السؤال، شخصاً مستهجناً أو وقحاً أو مُغرضاً وراءه ما وراءه. ومن جهة أخرى، لا تعني قدرة الصحافي أو الصحافية في بلدان العالم “الحر” نسبياً في طرح الأسئلة المُحرجة، أو في إعادة تكرارها، أن المسؤول سيتجاوب مع هذه الثنائية، بل يمكن له حتى أن يتهرّب من الإجابة بلغة خشبية أفرزتها الخبرة الإعلامية والحنكة السياسية. وفي المحصلة، أدّى الإعلامي دوره، وبدا واضحاً لمتلقٍّ واعٍ أن المسؤول يتهرّب من الجواب وله الحكم في هذه الحالة.
هاج وماج بعضنا عندما قابل صحفيان شابّان الرئيس أحمد الشرع على قناة سوريا، موجّهين إليه أسئلة عادية، فيها بعضٌ قليلٌ من تغييرٍ في النمط الاستلقائي والتمجيدي الذي طاب لنا، غصباً عن عقولنا، أن نعتبره المرجع في خمسة عقود من الترهيب والترغيب. واعتبرنا إذاً أنهما افتقدا اللباقة والاحترام للضيف الكبير بطرح أسئلة تعجيزية أو مكرّرة أو مقاطعاتٍ لا عهد لنا بها. أعدتُ مشاهدة المقابلة مراراً، لأجد أن فيها من اللباقة والكياسة ما يتجاوز الجرعة المحمودة. حينها تأكّد شعوري بأننا، نحن السوريين، ما زلنا في أجواء حكم خيّل لبعضنا أننا ثرنا عليه لأسبابٍ عدة، منها الحصول على حرّية التعبير والتوجّه إلى المسؤول أيّاً كان، وكأنه مسؤولٌ أمامنا فعلاً عن أمورٍ يمكن محاسبته على تحقيقها أو عدمه. وبعد تدجين الإعلاميين في الحقبة البائدة، تبيّن أيضاً أن التدجين أصاب بعضنا، متلقّين ومتابعين، فكيف نفسّر ردات الفعل السلبية التي وصلت إلى درجة البحث عن الكمائن اللفظية وما وراء الأكمة لدى مراسلة تلفزيون العربي في باريس، لأنها طرحت سؤالاً مهنياً بامتياز على الرئيس الشرع في مؤتمره الصحافي الأربعاء الماضي في باريس؟
سألته عن “المجازر” التي جرت في الساحل، وهي موثّقة من منظمات محلية ودولية، واعترف المسؤولون بوقوعها وشكّلوا لجنة تحقيق للبحث فيها. ومفردة المجزرة تستخدم للدلالة على قتل جماعي وعنيف لأشخاصٍ كثيرين. ولا تحمل عمليات القتل هذه تبريراً، ويعكس عنفها الجانب الوحشي من الإنسان. لهذه العبارة أن تستخدم في سياق تاريخي أو سياسي، وذلك عند الحديث عن أحداث دموية قتل فيها مدنيون أو أسرى او أي فئة من الناس لا تمتلك أدوات الدفاع عن النفس. كما يلجأ إليها عند التطرّق إلى الحديث عن جرائم حرب أو إبادة جماعية. وغالباً ما يقع استخدامها لتوصيف جريمة قتل جماعي لأسبابٍ عرقيةٍ أو دينيةٍ أو سياسية. يضاف إلى ذلك كله أن اللجوء إلى استخدام مفردة المجزرة لا يتطلب تحقيق حد أدنى من عدد الضحايا، فمقتلة محدودة لعدد محدود من البشر وبطريقة عنيفة ستتيح لمن سينقل أخبارها ويحلّل أبعادها ويصف نتائجها بأن يسميها مذبحة.
وسألته أيضاً عن وجود مفاوضات مع إسرائيل بخصوص اعتداءاتها الوقحة والإجرامية على الأراضي السورية. وهذا الموضوع يملأ الصحف ويتكرّر تناوله من الصحافة العالمية والعربية والإسرائيلية، فهل علينا أن نمعن في إدخال رؤوسنا في الرمال غير النظيفة حتى نكون واعين ومتحضرين لما تحفظه لنا الأيام المقبلة؟
لقد أجابها الرئيس الشرع بكل ارتياح وثقة، ولم يستشف من نبرته أي انزعاج أو تململ. فما بال الممجّدين من لَدُنّا يبالغون في الانحناء الذي، بعد عمر معيّن، يقصم الظهور؟
العربي الجديد
————————
عن ملف الفصائل الفلسطينية في سورية/ غازي دحمان
11 مايو 2025
تفتح حادثة توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، طلال ناجي، في دمشق بضع ساعات، وقبلها اعتقال عضوين في حركة الجهاد الإسلامي، الباب أمام سؤال مستقبل علاقة السلطة الراهنة في سورية بحركات المقاومة الفلسطينية والقضية عموماً، وعن المدى الذي ستصل إليه إجراءات السلطة الجديدة في دمشق في هذا الملف.
باتت العلاقة السورية الفلسطينية مرتبطة، إلى حد كبير، بالشروط الأميركية على إدارة الرئيس أحمد الشرع، الشروط التي على أساس تنفيذها سيجرى تقرير رفع العقوبات الأميركية، والتي باتت بدورها بمثابة المقرّر لمصير سورية في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت تستطيع الإقلاع والنهوض، أو الهبوط إلى مرتبة الدولة الفاشلة التي لا تستطيع تأمين الخدمات الضرورية وتسيير مؤسساتها.
هذه هي المعادلة التي تواجهها إدارة الشرع، التي تحاول توسيع مساحات التفاهم مع الإدارة الأميركية بأكبر قدر ممكن، في مناخ متوتر وضاغط تواجهه هذه الإدارة في سياستها الداخلية، والتأثيرات التي يفرضها عليها الصراع الجيوسياسي المحتدم حول سورية الذي تتولاه أطراف إقليمية، وتحديداً إسرائيل وإيران، في إطار سعيها إلى إيجاد مساحات فراغ سلطوية يمكن من خلالها تنفيذ أجنداتها الإقليمية، في وضع سوري غير مستقرّ، وينطوي على قابلية كبيرة للتشرذم، بالاتكاء على عاملي ضعف المركز الدمشقي، والنهوض الهوياتي في الفسيفساء السورية المعقّدة المقيمة، في الغالب، على الأطراف التي تملك فضاءات تواصل مع العالم الخارجي.
وقياساً بالتعقيدات التي تواجهها إدارة الرئيس الشرع في الملفات الداخلية، بالنظر إلى صعوبة إيجاد حلول حاسمة وشاملة بشأنها، في ظل عمليةٍ تفاوضيةٍ معقدة بين دمشق والفاعلين الداخليين، القوميات والطوائف، يبرز موضوع الوجود الفلسطيني، بالإضافة الى الشروط الأخرى الواردة في القائمة الأميركية، من نوع محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتصنيف الحرس الثوري وحزب الله جهات إرهابية، شروطاً سهلة يمكن التركيز عليها وتسليط الضوء على ما تقوم به إدارة الشرع في مجال تكيفها مع الشروط الأميركية، في سياق محاولاتها التموضع ضمن خريطة الأنظمة السياسية الطبيعية وإثبات أنها فاعل دولتي مندمج باللحظة الدولية ومتفهم لمتطلباتها الأمنية والسياسية.
تكمن سهولة الأمر في أن أغلب الفصائل الفلسطينية الموجودة في سورية كانت منخرطة في إطار محور المقاومة الإيراني. وفي الأصل، صمّم نظام الأسد الوجود الفصائلي الفلسطيني في سورية ليكون أحد عناصر تثبيت هيمنته الداخلية والاحتفاظ بدور إقليمي مؤثر من خلال ربط نفسه بالقضية الفلسطينية، والتي، رغم كل المتغيرات التي طاولت البيئة الاستراتيجية الإقليمية والواقع الدولي، حافظت على مكانتها التأثيرية وقدرتها على توليد ديناميكيات جديدة تؤثر على الاستقرار في المنطقة، وهو ما كشفته مخرجات عملية طوفان الأقصى التي غيّرت الوضع الاستراتيجي للمنطقة على نحو كبير.
والواضح أن إدارة الشرع، في تعاملها مع الملف الفلسطيني، تحاول تصدير موقفها على أنه من أشكال التعامل مع مخلفات النفوذ الإيراني في سورية والمنطقة، وإعطاؤها هذا العنوان للملف يمنحها هامش حركة واسعاً في ما قد تقوم به من إجراءات لتنفيذ الشرط الأميركي، كما تجنبها تهمة التخلي عن الفلسطينيين وقضيتهم، في وقتٍ تبحث فيه الإدارة السورية الجديدة عن كل ما يفيد تثبيت شرعيتها في الداخل والخارج، وهنا يمكن للإدارة اتباع الوصفة العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية وفاعليها، إذ من المعلوم أن غالبية الأطراف العربية تعاملت مع الملف الفلسطيني بطرق مواربة، بمعنى أنها حاربت فعلياً الفعل الفلسطيني المقاوم، وادّعت، من جهة أخرى، استمرارها بدعم القضية الفلسطينية وناسها، واكتفت بهذه السردية رغم اتضاح عيوبها وعدم فاعليتها على أرض الواقع، وكونها لم تكن أكثر من استراتيجية تبريرية للتخلي عن القضية الفلسطينية.
ما يؤكد هذه الحقيقة مسارعة إدارة الشرع إلى استقبال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع إدراكها أنه ليس العنوان الحقيقي للملف الفلسطيني، على الأقل، انطلاقاً مع فهمها الثوري طبائع الأمور، ومن حقيقة أنها سلطة ثورية رفضت الأمر الواقع في سورية وشرعية نظام الأسد الإشكالية. وقياساً على ذلك، كان يجب ألا تخدعها الصورة المصدّرة للقضية الفلسطينية وسلطة عبّاس بوصفها مجرّد واجهة ترضى عنها إسرائيل والبيئة الإقليمية. ولكن يبدو أن إدارة الشرع فضّلت التكيف مع مقتضيات المرحلة الإقليمية على مطابقة سياساتها بالقناعات والمبادئ التي تأسّست عليها.
وفي كل الأحوال، ورغم السهولة النسبية التي ينطوي عليها تعامل إدارة الشرع مع ملف الوجود الفصائلي الفلسطيني في سورية، سواء لضعف هذا الوجود وافتقاده هياكل فعلية على الأرض، أو بالأصل لوجود رأي عام بين فلسطيني سورية كاره لأغلب الفصائل التي لها وجود وتمثيل في دمشق، وميله بدرجة كبيرة صوب حركتي فتح وحماس، لأسباب تاريخية، إلا أن الأمر ليس بالسهولة المُتصوّرة، على الأقل، من وجهة نظر الأميركيين والإسرائيليين، إذ إن فتح هذا الملف سيجر الى الخوض في تفصيلاتٍ كثيرة، تشكّلت على مدار عقود من وجود هذه الفصائل في دمشق، وتشمل علاقاتها ببعض من المجتمع الفلسطيني السوري، مثل ملفات عائلات الشهداء وترتيب أوضاع العاملين في هذه الفصائل، والتشعبات الإقليمية لوجود هذه الفصائل وانتشارها على خريطة تشمل لبنان وفلسطين، والعراق أخيراً، وهذه مسائل يصعب تفكيكها بسهولة أو في وقت قصير، ما يُبقى هذا الملف قيد المتابعة إسرائيلياً وأميركيّاً، وبالتالي، يعطيهما مساحة لإبقاء الضغط على إدارة الشرع بذريعة عدم إيفائه بالشروط المطلوبة منه.
تدرك واشنطن وتل أبيب أن تأثير الفصائل الفلسطينية في سورية على الصراع مع الفلسطينيين ضعيف وغير فاعل، لكنه إيراده ضمن قائمة الشروط التي تفتح الباب لإزالة العقوبات نوع من التذكير بفائض القوة التي لديهما في المرحلة الراهنة، وهو أقرب إلى الشرط المفتوح دائما على سلسلة التفاصيل التي لا تنتهي، والمُراد منه إضعاف القوّة التفاوضية لدمشق في إطار سياسة إخضاعها للشروط الإسرائيلية الأميركية.
العربي الجديد
—————————————
نظام شرق أوسطي جديد: بالتفكيك.. أم بالتدمير!/ عبد المنعم مصطفى
الأحد 2025/05/11
أيهما يلد الاخر، ويسبقه، ويضع بصمته عليه؟!.. النظام الدولي أم النظام الإقليمي؟!.. من منهما يقتاد الآخر ويفتح له الطريق؟!
لقد صاغت حروب الثلاثين عاماً في أوروبا (1618-1648) نظاما إقليمياً أوروبياً بات يعرف بنظام ويستفاليا (صلح ويستفاليا)، أرسى بدوره القواعد لنظام دولي، دام حتى وضعت الحرب العالمية الأولى نهاية له، وفرضت على دول اوروبا، نظاماً دولياً جديداً أرساه صلح فرساي (1919)، الذي أنهته الحرب العالمية الثانية، التي صاغت بدورها إتفاق يالطا الثلاثي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا.
كان هناك دائما صراع في أوروبا، تقود نتائجه إلى نظام دولي جديد، عرفت معه البشرية، صيغاً للتنظيم الدولي مرتين، الأولى بقيام عصبة الأمم فوق أنقاض عالم ويستفاليا، والثانية بقيام الأمم المتحدة فوق أنقاض عالم فرساي.
ما يحدث الآن أمام ناظرينا هو تفكيك النظام الدولي- الذي أرست قواعده صيغة يالطا – بديلاً عن تدميره.
عملية التفكيك بدأت في تقديري باستدراج الاتحاد السوفياتي السابق (روسيا الآن) إلى التورط بغزو أفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1979، واستنزافه فيها حتى شباط/فبراير 1989، حين اضطر السوفيات إلى الانسحاب من أفغانستان بينما كان الاتحاد يتعرض لأخطر عملية تذويب تتعرض لها قوة عظمى كانت تملك في لحظة الانهيار، أضخم ترسانة نووية عرفها التاريخ.
بانهيار الاتحاد السوفياتي، انهار معه حلف وارسو (تأسس عام 1955 رداًعلى انضمام ألمانيا الغربية إلى حلف الناتو، وضم عند التأسيس كل من الاتحاد السوفياتي، وألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا وبولندا وألبانيا) وانهار معه النظام الدولي الذي أنتجته الحرب العالمية الثانية.
وبينما كان الغرب يؤلف ويقرأ كتاب “نهاية التاريخ” لفرانسيس فوكوياما، و”صراع الحضارات” لصموئيل هنتجتون، احتفالاً بانتصاره التاريخي في حرب كونية ثالثة انهار فيها الخصم المنافس دون طلقة “نووية” واحدة، كان المسرح الدولي يتأهب لصراع جديد، أراد الأميركيون أن يفرضوا نتائجه على العالم لمئة عام أخرى جديدة، فخرج الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على العالم رافعاً شعار “we should prevail” (يجب أن نسود)، موضحاً أن القرن المقبل يجب أن يكون أميركياً.
كان بيل كلينتون حين فاز بالرئاسة لأول مرة عام 1992، هو أول رئيس أميركي مولود بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يعني أن الرجل سيدير العالم بقوانين جيله، بدون قطبية ثنائية، وبدون حرب باردة، وبدون سباق تسلح.
وبدا أن أميركا المنتصرة في الحرب الباردة دون حرب -كما توقع رئيسها الجمهوري ريتشارد نيكسون في كتابه “victory without war” (نصر بلا حرب)- تتأهب لبسط قوانينها على العالم، وهو ما جرى ويجري على مدى قرابة نصف قرن. حيث تمارس الولايات المتحدة إدارة النظام الدولي القائم باعتبار أنه نظام أحادي القطب يجلس فيه العالم كتلميذ بليد في حصة إملاء دولية، يتلقى فيه الآن إملاءات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي ركل باب العالم بمقدمة حذائه الكلاسيكي، وراح يدسّ أنفه في كل شأن، ويملي إرادته في كل أمر.
عالم دونالد ترامب، شهد ويشهد تحديات تفرضها ولادة مستحقة لنظام دولي جديد يقرع بقبضته القوية أبواب العالم، في ثلاث بؤر حاسمة، إحداها هنا عندنا في منطقتنا، والأخرى في أوكرانيا، حيث قلب أوروبا الذي يغير العالم كلما جاءه مخاض التغيير، أما الثالثة فهي في الشرق الأقصى حيث مخاض صراع دامٍ تتحد به الصين وتكبر، أو تخفق في سداد فواتيره فتصغر.
بؤرة المخاض الدولي في منطقتنا، هي ذروة مخاض لولادة نظام إقليمي شرق أوسطي جديد، يبدو من مجرياته حتى الان، أنه يقتادنا بشراك خداعية إلى حفل تقيمه إدارة ترامب في منطقتنا لتنصيب إسرائيل زعيمة لنظام إقليمي شرق أوسطي جديد، يجري الآن تهيئة مسرحه لحفلات بسط الإرادة بالقوة، انطلاقاً من سوريا، كما اعتادت المنطقة عبر تاريخها الطويل والممتد.
قبل أكثر من مائة عام، كانت سوريا هي غرفة الولادة لنظام إقليمي جديد (آنذاك) أصبح معروفاً فيما بعد باسم الشرق الأوسط، الآباء الأوائل للشرق الاوسط القديم باتوا معروفين لنا، بعدما سمحت السنين بكشف هوياتهم على أنهم (سايكس- بيكو- سازانوف)، ممثلي بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية على التوالي.
والآن، بعد أكثر من مئة عام على ولادة الشرق الأوسط، تعود سوريا بموقعها الاستراتيجي، وبتركيبتها الفريدة لتستضيف الولادة الثانية لشرق أوسط جديد.
المشهد على الأرض في سوريا، وفي دهاليز السياسة في واشنطن، يشير إلى بداية جديدة لحرب جديدة بأدوات جديدة، فوق ذات المسرح السوري القديم.
الهدف الأول، إقصاء إيران خارج معادلات النظام الإقليمي الشرق أوسطي الجديد، والهدف التالي، إقصاء تركيا خارج معادلات النظام الإقليمي المنتظر، أما الهدف الثالث فهو تمكين إسرائيل بالقوة من قيادة مشهد إقصاء إيران أمام ناظري القوى الإقليمية العربية، ليقرر بعدها العرب ما إذا كانوا في وارد المواجهة مع إسرائيل التي توحدت مع الولايات المتحدة، أم أنهم يفضلون إرجاء خيار المواجهة إلى زمن لاحق ترفق فيه الدنيا بحالهم.
المدن
————————–
مأزق سياسة الاحتراب الأهلي/ ورد كاسوحة
السبت 10 أيار 2025
ثمّة ما يتجاوز العودة عن الحداثة السياسية لدى السلطة الحالية في سوريا. فلو اقتصَرَ الأمر على أشكال محدّدة من الممارسات التي تنطوي على بعد أهلي أو ديني، وصولاً حتى إلى استعادة سياسات الأعيان والإقطاع القديم، لأمكن تجاوزهُ، ووضعه في خانة الممارسات النقيضة لـ«التحديث القسري»، الذي أتى به «البعث». لكن ما يتضح الآن، وبعد أشهرٍ خمسة على سقوط النظام السابق، أنّ ثمّة منهجية تضع سياسات الهويّة، ومن دون امتلاك أدواتها أو فهم فلسفتها حتى، في صُلب البنية السياسية للنظام الحالي.
غَلَبة البُنى الأهلية النابذة للسياسة
استبعاد الأحزاب كلّياً من الخريطة السياسية الجديدة، حتى تلك المعارِضة سابقاً منها، وتفضيل الوجاهات والأعيان والمرجعيات الدينية عليها، يوضح إلى أيّ حدّ تذهب السلطة الحالية في إخراج السياسة من منهجها لمصلحة الهويّة بمعناها الأوسع. أي تلك التي يمكن عبرها تبرير حصر الصراع السياسي، إذا صحّ وجوده أصلاً، بين أطراف لا تشبه بعضها فحسب، لجهة البعد الأهلي بمعناه الضيّق، بل أيضاً يحصل بينها تقاطعات وتخادُم، حتى حين تكون في حالة خصومة مُعلَنة.
ذلك أنّ البنية التجزيئية للسلطة، التي تتغذّى على تذرير الحداثة السياسية السابقة وتفكيكها، تستدعي، ليس فحسب ما يشبهها، في البيئات الأهلية الأخرى، بل أيضاً ما ينقل حالة الاستقطاب الأهلي، من البعد السياسي الذي يكون فيه الصراع سلمياً وتقدّمياً ونابذاً للعنف، إلى نظيرِه العسكري، الذي يقوم على الاحتراب الدائم.
حتى الاحتراب نفسه ــــــ الذي عادةً ما يخضع لدى اعتماده كمنهج من جانب النظم الشمولية لضوابط محدّدة تستبعد المساس بالروابط الاجتماعية التي تقي المجتمع خطر التفكّك ـــــ يتحوّل هنا إلى أداة سياسية لاستهداف هذه الروابط بالتحديد. فالعنف في مواجهة الجماعات الأهلية، كما يَظْهر حالياً، ليس منفلِتاً أو مستخدَماً على نطاق ضيّق بواسطة أفراد، بل هو نتاج منهجية الاحتكام إلى السلاح بدل السياسة في مقاربة الملفّات التي يعجز النظام عن إيجاد حلٍّ لها، ضمن الفضاء الحداثي المدني، بحكم افتقاده كسلطة أمر واقع إلى أدواته.
دور الفضاء المدني في كبح العنف السياسي
وهو ما يفسّر، من ضمن أمور أخرى، شيوع الجريمة عوضاً من ضبطها، واللجوء إلى «القصاص الميداني» الذي لا يستثني المدنيين، أثناء معالجة «حالات الإفلات من العقاب»، هذا إذا صحّ في التصفيات الحاصلة تسمية القصاص أصلاً.
ما يفعله الفضاء السياسي المدني، في المقابل، لو أُتيحت الفرصة لفاعليه من سياسيين وكُتّاب ومثقفين وحقوقيين وناشطين الفرصة، هو ليس فقط ضبط الصراع وعقلنته، إذ تُلجم نزعة العنف التي ينطوي عليها استخدام السلاح كيفما كان وفي مواجهة الجميع، بل أيضاً تزويده بأدوات القوّة الناعمة، المتقاطعة بشدّة مع الفضاء المدني السلمي، والمتداخلة مع الأشكال أو الأنماط السياسية، المعنيّة بدورها بنزع العنف من المجتمع نهائياً وعلى نحو كامل. حين يحصل ذلك بمقدارٍ معيّن، وعندما تصبح الفرصة متاحة بالتالي لإدارة الخصومات بمنطق يعلو فيه التسييس، حتى للهويّات الجزئية العصيّة عليه عادةً، فهذا يعني غالباً كبح منطق الاحتراب الدائم والانتهاء إلى مآلٍ أفضل بكثير من الوضع الحالي.
على اعتبار أنّ الوضع ينذِر، مع تصاعد وتيرة العنف الأهلي المسلّح واتضاح حجم الاشتباك التركي الإسرائيلي هنا، بتصدّعات أكبر وأكثر حدّة، على صعيد الجغرافيا الاجتماعية والسياسية للبلاد.
خاتمة
طبعاً، هذا لن يضعف الاستخدام الجيوسياسي للورقة السورية من جانب الأطراف المتدخّلة هنا، كون سوريا الآن ليست في موقع يسمح لها باستعادة أيّ دور إقليمي فاعل، فكيف بمواجهة من يحاول إضعافَها واستخدامَها كورقة للمساومة والصراع على النفوذ والدور في الإقليم والعالم. ومع ذلك، يمكن لتشريع الفضاء المدني، إذا ما حصَلَ توافقٌ أو إجماع على الاحتكام إليه داخلياً، أن يخفّف الاحتقان في الداخل، ويعطي الجميع مجالاً لالتقاط الأنفاس، بما يحقن الدماء، وينقذ حتى قاعدة السلطة الاجتماعية من تبعات خيار «الحسم العسكري». أي لجهة الفوضى الشاملة التي يقود إليها منطق الاحتراب انطلاقاً من الحلقة المفرغة لتناظُر المظلوميات السابقة واللاحقة أو تضادّها.
* كاتب سوري
الأخبار
—————————-
هل يحتاج السوريون إلى لمّ الشمل أم إلى تفريقه؟/ أحمد جاسم الحسين
2025.05.11
“هلوا واحنا نهل، يا محلا لم الشمل، يا دنيا خلي أحبابنا، يضوون شمعة بابنا وعيونكم ما نمل”
تلك أغنية للموسيقار العراقي الدكتور في الأدب العربي فاضل عواد، غناها قبل نحو نصف قرن، إذ لم تكن رحلة تفريق الشمل أو لم الشمل السورية الحالية قد بدأت. جملة “لمّ الشمل” تردّ على الفرقة والتفرق والفراق، ولهذه المفردات حضور كبير في الثقافة العربية التي كان جزء كبير منها يتسم بالترحال.
جملة “لمّ الشمل” أبرز مفردة عرفتها رحلة اللجوء السورية، حيث يصل أحد أفراد العائلة البالغين إلى أوربا نظراً للتكاليف المادية الكبيرة لو جاؤوا معاً، ثم يقدم طلب لمّ شمل لأفراد عائلته (الزوجة أو الزوج أو الأولاد). أو يصل طفل تحت الثامنة عشرة ليلمّ شمل أهله وإخوته تحت الثامنة عشرة، وتفرعت قصة لم الشمل السورية حتى غدت أحد عوامل الضغط على اللاجئين كي لا يأتوا إلى هذا البلد أو ذاك، ولكن محاكم أوربية عدة قررت أن تأخير لمّ الشمل فيه كثير من اللاإنسانية، لأن حق الشخص بالعيش مع أسرته حق مقدس.
وقد شهد هذا الملف كثيراً من التطورات منها مثلاً ما يحدث في أثناء الغياب كأن يحب الرجل امرأة أخرى أو تحب المرأة أحداً آخر في أثناء الغياب، أو تحدث تبدلات نفسية أو شكوك أو سوى ذلك، أما إرسال الأطفال وخطورات الطريق، فعدّه كثيرون جريمة! في حين عده الأهل أنه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تلك البلاد الصعبة السهلة!
وتفتحت كثير من التفاصيل في هذا الطريق، صارت أقرب إلى الاستغلال كأن يدعي أحد الأطراف أنهم ربوا طفلاً ما في بيتهم ويسمح لهم بلمّ شمله، ثم حين يصل الطفل يقوم بلم شمل أهله مقابل مبلغ مادي لمن أحضروا الطفل، أو الادعاء بوجود زوجة سابقة أم لأحد الأطفال حيث تقوم هي بلم شمل أطفالها…وهكذا…
كان طريق لم الشمل طريقاً متعباً جداً فيه كثير من العثرات، لأن أس عملية البناء وإعادة البناء تعني أن خلخلة ما قد حدثت، لذلك فإن إعادة الهارموني إلى سيرته الأولى ليس أمراً سهلاً!
اليوم يبدأ سوريون من شرائح أخرى برحلة الهجرة وبالتالي في مرحلة أخرى “لم الشمل” بدافع الخوف أو عدم الشعور بالأمان أو أنهم تعرضوا لمخاطر ما، المهم أن خوفاً لا يزال ينتشر بالبلاد!
ما سبق يمكن أن يسمى بـ لم الشمل القانوني ذي الآثار الاجتماعية والنفسية والعائلية والشخصية.
أما بعد إعلان النصر في سوريا في 8-12-2024 فقد بدأت دلالة جديدة لرحلة لم الشمل، من خلال السفر إلى سوريا من مختلف بلدان العالم، عبر العودة لرؤية الأهل أو العودة إلى العمل السابق، وهكذا بدا أن رحلة لم الشمل السورية لا نهاية لها، لأن الفراق أحد الأقدار الرئيسية التي لم تنفك عن زيارة حياة السوريين.
لمّ الشمل لغوياً توصل دلالة لقاء العائلة أو الأحبة أو الأوطان بعد فراق، وهي تريد القول: إن تفريق الشمل ليس حدثاً مرحباً فيه، بل إن شبه الجملة إحدى أدوات الدعاء على الأعداء (اللهم فرق شملهم) والتمني للأحبة (اللهم اجمع شملهم)!
بدا أن السلطة السورية الحالية تحاول أن تجمع شمل سوريا مع النظام العالمي والمحيط الإقليمي، وهو حدثٌ نظر إليه السوريون بإيجابية، لأنه لا يوجد عاقل يعتقد اليوم بأن بناء الأسوار على الحدود مع الآخرين هو أفضل الحلول، كي تمشي الدول والبشر إلى الأمام
الخطوة الكبيرة التي ينتظرها السوريون من الحكومة السورية الحالية هي لمّ شمل سوريي الداخل معها وكذلك مع بعضهم بعض!
كيف ومتى وأين ولماذا؟ لكن هل الخطوة منتظرة من الحكومة وحدها؟ وهل هي الأولوية؟ وما أدوات الحكومة للقيام بذلك؟
ما دور المجتمع المدني السوري في ذلك؟ خاصة أن الواقع يكشف أن أمامه فضاء كبيراً للعمل، فلماذا لا يعمل؟
من المهم في جهود لمّ الشمل أن لا تنشغل مجموعة بلم الشمل في حين تقوم مجموعات أخرى بتفريق الشمل، وبين اللم والتفريق ستضيع الطاسة السورية.
من الثابت أن جهود لمّ الشمل أبطأ بكثير من جهود تفريق الشمل، بخاصة في مراحل النزاع، لأن النفوس لديها قابلية للاستماع للسلبي نتيجة للخوف أو عدم الثقة بالآخر، أو استحضار الماضي في ظل عدم وجود هوية وطنية جامعة أو عقد اجتماعي أو مصلحة مشتركة.
أحسبُ أن “إدارة الشؤون السياسية السورية” التابعة للسلطة الحالية هي من أهم الجهات التي يمكن أن تبدأ هذا الحوار، مع كل الأطراف السورية، لأن المشهد السياسي السوري حالياً فيه كثير من الجهود المتضاربة، وأقلها حضوراً هو العمل السياسي ذو البعد الاجتماعي.
الواقع يكشف أننا في لحظة شحن فئوية سورية صعبة، إلى درجة أن كثيرين ممن يفترض أن يكونوا عامل لم شمل باتوا مفرقي شمل!
ولو دعوناهم لنردّد معاً أغنية فاضل عواد: “يا محلا لم الشمل” سيقولون: قبل أن تتحدث عن اللمّ يجب أن يكون هناك شمل لنلمه. وكذلك أسس للم الشمل وليس سيطرة طرف على طرف آخر، ربما يكونون محقين أو مخطئين، لكن لا بد من بداية لأي فكرة نريد أن نتحاور حولها!
شخصياً، أحسبُ أن قراءة تاريخ سوريا تكشف أنه لا حلّ أمام السوريين سوى البحث عن أسس يجتمع عليها السوريون للمّ الشمل القانوني والاجتماعي والنفسي والديني والأخلاقي والريفي والمديني، لأن تفريق الشمل سيضرُّ الجميع، ولا طائل منه ولا فائدة، بل تضييع لسنوات جديدة من عمر سوريا، التي يتفق الجميع على حبها، كل بطريقته ولديه أسبابه!
لمّ الشمل السوري المنتظر لا يعني أن يصبح السوريون نسخة واحدة، بل أن يبحثوا عن المشتركات وترميم الذات وعلاقتها مع الآخر.
لا يمكن أن نبدأ بلمّ الشمل من دون أن نجد مصلحة مشتركة لنا فيه، فهل من أسباب تجعلنا نحرص على لمّ الشمل؟ أم أن المزيد من تفريق الشمل هو الأفضل؟
ليست الدعوة إلى لمّ الشمل هنا دعوة من سارد عليم أو مثقف بعيد عن الناس، بل للاعتقاد أن مصلحة معظم السوريين تكمن فيه، استجابة لقدرهم الجغرافي والديمغرافي، والشخصية السورية التي تركت بصمة في تاريخ العا
—————————————-
هل تعيد القرارات الجديدة الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟/ نور ملحم
11 مايو 2025
في ظل الأزمة المصرفية التي ترهق السوريين، باتت سياسة المصرف المركزي القائمة على حبس السيولة النقدية جزءاً أساسياً من معاناة يومية تواجه المواطنين. فمنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حاول المركزي ضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عبر فرض قيود صارمة على السحب والإيداع، إلا أن امتداد هذه السياسة لسنوات خلق فجوة عميقة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق، ما زاد من الضغوط الاقتصادية وأثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية.
ومع تفاقم الأزمة المصرفية واستمرار قيود السحب، اضطر المواطنون إلى البحث عن بدائل معقدة للحصول على أموالهم، وسط معاناة تجسّدها قصص يومية لآلاف الأشخاص. حسن الأيوبي، الموظف الحكومي، يقضي أياماً في محاولة سحب راتبه، بينما ليلى الأطرش، صاحبة المحل التجاري، تخشى انهيار تجارتها بسبب تعثر تحويل الأموال. في المقابل، يجد أبو محمد، عبد الله الجزماتي، الرجل المسن الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، نفسه عالقاً في دوامة الإجراءات المصرفية، فيما يرى يوسف المحمد، الشاب الطموح، أحلامه بالتوسع في مشروعه تتلاشى أمام عراقيل السحب البنكي.
حبس السيولة
في محاولة لمعالجة أزمة السيولة النقدية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي برفع سقف السحب النقدي للحسابات المغذاة بإيداعات جديدة بعد 7 أيار/مايو 2025. هذه الخطوة، التي تأتي وسط تراجع ثقة المواطنين بالمصارف نتيجة القيود المشددة على السحب، تطرح تساؤلات حول مدى فاعليتها في التخفيف من وطأة الأزمة النقدية.
ويؤكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن القرار يهدف إلى معالجة الوضع الراهن الناجم عن شح السيولة، مشدداً على أن حقوق المودعين، سواء أصحاب الحسابات القديمة أو الجديدة، ستظل مصانة، إذ سيجرى التعامل مع الودائع القديمة بشكل تدريجي لضمان استقرار سعر الليرة السورية وتجنب مخاطر التضخم. ويكشف المصدر لـ”العربي الجديد” أن عدد الحسابات المصرفية الجديدة المفتوحة والمفعلة قبل صدور القرار بلغ حوالي 2.5 مليون حساب، وسط توقعات بأن يشهد القطاع المصرفي إقبالاً واسعاً على فتح حسابات جديدة بعد القرار سعياً للاستفادة من التسهيلات المالية الممنوحة.
ورغم أن الخطوة تتماشى مع المعايير المالية الدولية، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار سياسة تجفيف السيولة وعدم منح القطاع المصرفي حرية ممارسة دوره الحقيقي في تمويل المشاريع الإنتاجية سيؤثر سلباً على الاستثمارات، خاصة في ظل عزوف الصناعيين والمستثمرين عن إيداع أموالهم في المصارف بسبب العقوبات وعدم توفر فروع خارج البلاد.
حلول مؤقتة
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات قد تساعد مؤقتاً في احتواء الأزمة المصرفية، لكنها لا تشكل حلاً جذرياً لمشكلة نقص السيولة التي تعاني منها البلاد. ويشددون على أن دعم الإنتاج وتحرير نشاط المصارف من القيود هما الطريق الأمثل للنهوض بالاقتصاد بعيداً عن الحلول المرحلية التي لا تعالج جذور الأزمة. وقال الخبير الاقتصادي حازم عبد الكريم إن التعميم الأخير الصادر عن المصرف المركزي السوري لا يمثل تخلياً عن سياسة حبس السيولة النقدية التي اتبعها المصرف خلال السنوات الماضية، بل يعد توجهاً جديداً يضيف سياسة ثانية إلى المشهد المصرفي، إذ تستمر القيود على الحسابات القديمة، فيما تُتاح حرية أكبر للإيداعات الجديدة.
وأشار الاقتصادي السوري في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن هذا النموذج، الذي يُعتبر استنساخاً جزئياً لتجارب دول عربية واجهت أزمات مصرفية، يتبع أسلوباً يقوم على تقسيم الحسابات البنكية إلى قسمين: الأول يضم الإيداعات القديمة وتُعامل على أنها ديون طويلة الأجل تُسدَّد وفق تحسن الظروف المالية للمصارف، فيما يتيح القسم الثاني حرية الإيداع والسحب من دون قيود. لكنه يرى أن هذه السياسة، رغم محاولتها تحفيز التعاملات المصرفية، قد تؤدي إلى نتائج سلبية في ظل استمرار القيود على السيولة، خاصة مع عزوف المستثمرين والصناعيين عن إيداع أموالهم في المصارف بسبب العقوبات وعدم توفر فروع خارج البلاد.
وحذر عبد الكريم من تأثيرات تجفيف السيولة النقدية على السوق، إذ يؤدي نقص السيولة بين أيدي المستوردين والعملاء إلى اختلال في حركة البيع والشراء، ما يخلق ظروفاً استثنائية قد تفضي إلى خسائر أو أرباح غير محسوبة. ويضيف أن هذه السياسة ليست سوى إجراء مرحلي لمعالجة العجز المالي، لكنها لا تصلح نظاماً دائماً، إذ تقلل فرص الاستثمار وتحدّ من دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية، وهو أمر أساسي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
إعادة هيكلة
وشدد الاقتصادي السوري على ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي، مؤكداً أن استمرار سياسة تجميد الأموال في المصارف سيقلل من الفرص الاستثمارية ويؤدي إلى تراكم الأزمات المالية. ويرى أن الحل لا يكمن في السياسات النقدية وحدها، بل في دعم الإنتاج الحقيقي، مشيراً إلى أن استمرار تقييد نشاط القطاع المصرفي سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة إلى منح القروض للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج. كما يؤكد أن الخدمات المصرفية في سورية حالياً تُعتبر في أدنى مستوياتها، وهو ما ينعكس على توقعات العملاء وثقتهم بالقطاع المالي.
ولفت عبد الكريم إلى أهمية تجاوز البحث عن مبررات للعجز، والانتقال إلى خطوات عملية لإصلاح المنظومة المالية بما يسهم في دعم الاقتصاد بشكل مستدام. مع استمرار سياسة حبس السيولة وانقسام الحسابات البنكية بين قديمة وجديدة، يواجه الاقتصاد السوري تحديات تتطلب حلولاً جذرية، لا تقتصر على تعديلات إدارية وإنما تمتد إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وضمان قدرته على دعم الإنتاج والاستثمار، وبينما ينتظر المواطنون تنفيذ القرار، تبقى التجربة هي المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاح هذه السياسات في كسر القيود المصرفية وتحقيق انفراج اقتصادي حقيقي.
العربي الجديد
————————-
علمانية الطوائف السورية/ ابتسام تريسي
12/5/2025
مصطلحان اثنان نالهما الابتذال أكثر من أيّ شيء مبتذل في الواقع السوري اليوم، الأوّل لوضع العصي بالعجلات، والثاني لتعطيل تحقيقه، وهما العلمانية، والعدالة الانتقالية. فأن تطلب العلمانية من حكومة جاءت من منبت ديني متشدد فهذا يعني أنك لا تريد لهذه الحكومة أن تحقّق أيّ هدف وضعته رغم تخليها (خطابيًا) عن هذا التشدد. أمّا عمليًّا فتحتاج لبعض الوقت؛ كي تحوّل أقوالها لأفعال، هذا الوقت الذي لا يريد المعترضون السوريون أن تحصل عليه.
أمّا العدالة الانتقالية -إن تحققت- فستطول رؤوسًا كثيرة جدًا لا يرغب المعترضون بأن تُحاسب، وكثير منها يُشكّل قوام القوة العسكرية التي حاولت الانقلاب على السلطة الجديدة، بدايةً في الساحل السوري، ثمّ في الجنوب السوري، وهذا يُفسِّر حالة التعنت الشديد الذي يتمسك به “حكمت الهجري” القائد الروحي لجزء من الدروز، والمتبني للمجلس العسكري الذي يريد تحرير دمشق من سلطة الأمر الواقع.
شعارات المعارضة الحديثة
“نريد سوريا علمانية مدنية يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، ويكون للمرأة دورٌ بارز في إعادة بناء الدولة”. شعار سمعناه آلاف المرات من نخب ثقافية بارزة حينًا، ومتواضعة أحيانًا، نادى به مثقفون سنّة يساريون، ومثقفون علويون، ودروز، وأكراد، وامتلأت به مساحات السوشيال ميديا المقروءة، والمسموعة، والمرئية.
لن أتطرق بالشرح لمفهوم العلمانية فهو متاح لكلّ باحث، لكنّي سأذكر أحد الآراء التي رجعت للعصر الأندلسي واستخرجت بذرة الفكرة من ذلك العهد، إذ لما رأى المسيحيون في الأندلس المسلمين وعلاقتهم بربهم -حيث لا واسطة بين المسلم وربه- طالبوا بأن يكونوا مثلهم، وأن يجدوا طريقة يتخلصوا بها من الوسيط بين المسيحي وربه، هذا الوسيط الذي يبيعهم صكوك الغفران، ويفرض عليهم الأتاوات، ويتواطأ مع الملوك لإخضاعهم لسلطة الكنيسة، نمت هذه البذرة، وتكاثرت أغصانها لتغدو في زمن الثورة الفرنسية شعارًا يردده الفرنسيون جميعًا (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس).
مأزق اليساريين السوريين
لقد مرّ زمن طويل جدًا ليقتنع عامة الناس بفكرة العلمانية التي فرضها الشعب عبر ثورة عظيمة بعد أن هضم الفكرة جيدًا. أمّا في سوريا وفي بلادنا العربية عمومًا، فغالبًا لا نجيد إنتاج الأفكار، ونستسهل استيرادها، ونبرّر ذلك بحجة الاستفادة من تجارب الشعوب بغض النظر عن مكونات الخلطة الكيميائية المتباينة بين هذه الشعوب، ونتوقع دائمًا الحصول على النتيجة ذاتها. فاليساري السوري الدرزي ينضوي تحت لواء شيخ العقل، ويمتثل لأوامره، ومن ناحية ثانية يمنع الميراث عن أخته، وإذا تزوجت من غير الطائفة يقتلها، وفي الوقت نفسه يُطالب بدولة علمانية، حتى أنّ الابتذال وصل حدَّ مطالبة شيخ العقل ذاته بدولة علمانية وفي الوقت نفسه يضع على بدلة رجل الأمن الذي عيّنه شعار (يا سلمان) فكيف يطالب الشيخ بفصل الدين عن الدولة، أليس من الأولى أن يعزل نفسه أولاً، ثمّ يتقدم بمثل هذا الطلب؟
العدالة الانتقالية القشة التي يتعلّق بها المجرمون
أمّا عن العدالة الانتقالية فلا ذكر لها عند الشيخ حكمت ومجلسه العسكري وقد وصل به الأمر حد المطالبة بإعادة عناصر الجيش، ودفع رواتب للمجرمين المختبئين في مجلسه العسكري، رغم أنّ بعضهم من كبار المجرمين في العهد البائد.
في الجانب الآخر، وكي لا يبدو الأمر دفاعًا عن طائفة بعينها نجد بعض اليسار السنّي يقع في الحفرة ذاتها إذ نراه يتلعثم عند ميراث أخوته البنات، وقد يستعيد إيمانه بالله إن اقتضت المصلحة ذلك.
أما الجماعة الكردية التي تأوي عصابة قنديل (pkk ) فالأمر لا يتوقف عند هذه التناقضات، بل يتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك فاختطاف القاصرات والأطفال وتجنيدهم عسكريًا في خدمة حزب العمال الكردستاني يُعد جريمة الجرائم التي لا يقبل بها دين أو نظام علماني على وجه الأرض، ومع ذلك يريدون سوريا علمانية.
الأسد فكرة والفكرة لا تموت!
هذا الواقع الأسود الذي تعيشه سوريا اليوم، هو نتاج طبيعي لما أفرزه الاستبداد الأسدي الذي جعل من السهولة بمكان ارتباط بعض المكونات بأجندات خارجية تلعب في الملف السوري كما تشاء مصالحها، يُساعد في ذلك مجمل الأخطاء التي وقعت فيها السلطة الجديدة والتي تحاول جاهدة تسوية النزاعات بطرق سلمية قد تضطرها لتنازلات هي بغنى عنها، خاصة وأنّها تعلم جيدًا أنها مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي بدستور يرضى عنه العالم (المتحضر) قبل الشعب السوري الذي ما زال ينتظر العدالة الانتقالية، ورفع العقوبات الأمريكية عنه؛ كي تبرأ جراحه.
وعلى هذا الأساس ينظر السوريون المعتدلون إلى النشاط الخارجي للرئيس الشرع نظرة أمل لإيجاد حلّ للوضع السوري في أقرب وقت، بينما يحاول الطائفيون العلمانيون التغطية عليه بنشر قصص الخطف والاضطهاد من قبل الدولة الإرهابية.
فقد طلب مشايخ الدروز من العائلات الدرزية إعادة أبنائهم من جميع الجامعات السورية إلى السويداء، وانتشرت الفيديوهات التي علّق عليها الإعلامي الدرزي المعروف بمواقفه المُشرّفة من الثورة السورية منذ انطلاق شرارتها الأولى، قائلًا: “الرحيل الجماعي لطلاب السويداء من جامعاتهم في المحافظات السورية -بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم على خلفية انتمائهم الديني-خبرٌ لن تجد له أثرًا في الإعلام المسمّى وطنيًّا! يا لعارنا!”. وللأسف لم يكن ماهر شرف الدين وحده الذي تبنّى التحريض الطائفي علنًا، بل كثر من مثقفي وإعلامي الطائفة.
وعلى الطرف الآخر ارتفعت نسبة شيطنة السنة من قبل العلويين الذين ركبوا ترند “السبي” فراحوا ينشرون صورًا لفتيات مخطوفات على أنّهنّ سبايا “الأمن العام” وأنّ إدلب صارت سوقًا للسبايا. ويتبين بعد أيام أنّ الخبر كاذب، وتظهر الفتيات في فيديوهات مسجلة ينفين تعرضهنّ للخطف، لكنّ المحرضين لا يتوقفون، ويستمرون في تسويق أوهامهم التي يتمنّون لو كانت حقيقة؛ كي يستطيعوا الطعن في الحكومة وتكريس صفة الإرهاب عليها.
المصدر : الجزيرة مباشر
——————————
عن رفات جنود إسرائيليين في سورية/ حسام أبو حامد
13 مايو 2025
لم تكن تفصلني سوى خطوات قليلة عن السور الجنوبي لمقبرة الشهداء (المقبرة القديمة) الواقعة في حي المغاربة، جنوب شرقي مخيّم اليرموك. ما زلت أذكر تلك الليلة (1998)، حين خرجت من منزلي قرابة الساعة التاسعة قاصداً محلّ بقالة قبالة السور. فوجئت بعناصر أمن عسكري يسدّون الطريق ويطلبون مني العودة. في دقائق، تجمهر عدد من الجيران. علمت (وغيري) أن رجال الأمن طوّقوا المقبرة، وغطّوا سماءها بسواتر من قماش. أحد الجيران نقل عن قريبٍ له، بين العناصر التي طوّقت المقبرة حذّره من الاقتراب أكثر، أنهم يستخرجون رفات جندي إسرائيلي. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وأصبح حديث بيوت المخيّم، لكن صحيفة لبنانية نشرت صبيحة اليوم التالي خبراً مقتضباً مفاده: الأمن السوري ينبش رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد (!) الذي كان حديث وسائل الإعلام في حينه.
أنعشت تلك الحادثة ذاكرة المخيّم، فعادت بأصحابها إلى 1982، حين اخترقت شوارعَ المخيّم دبابةٌ (مغاح 3) إسرائيلية قدمت من لبنان، فوقها جُثَّتا جنديَّين إسرائيليين سار خلفهما أبناء المخيّم مهلّلين هاتفين، ومعها استعادت الذاكرة ما يقال إنه وعيد آرييل شارون لأبناء المخيّم: “لك يوم يا مخيّم اليرموك”.
زخاريا باومل وتسيفي فلدمان ويهودا كاتس، ثلاثة جنود إسرائيليين أُسروا (قتلى أو أحياء) في معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني (10/6/1982)، حين نصبت قوّة من الجيش السوري، تساندها قوات فلسطينية ولبنانية، كميناً محكماً لكتيبتَي دبابات إسرائيليّتَين حاولتا التقدّم لاحتلال طريق بيروت دمشق. انتهت المعركة بهزيمة إسرائيلية موجعة. كان الجنود الثلاثة طاقم الدبابة التي أصبحت واحدةً من غنائم المعركة، وسلّمها النظام السوري لاحقاً للاتحاد السوفيتي لفحصها، بما أنها نسخة معدّلة من الدبابة “M48” الأميركية، ليعيدها فلاديمير بوتين إلى نتنياهو في 2016.
لم تكفّ إسرائيل بحثاً عن رفات جنودها، وأخبرني أصدقاء حوصروا في المخيّم، أنه خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) (2015 – 2018)، وحتّى قبلها بعام، شهدت المقبرة نشاطاً مشبوهاً، واستاء الأهالي غير مرّة ممّا اعتبروه تعدّياً على حرمة الموتى، غير مصدّقين ادّعاءات العناصر المسلّحة بأنهم يبحثون عن أسلحة ومتفجّرات دُفنت في المقبرة، بل اقتحم مجهولون منزل مدير الدائرة السياسية في منظّمة التحرير، أنور عبد الهادي، بحثاً عن تصاميم ومخطّطات هندسية للمقبرة، ورُصدت عمليات تهريب (فردية) لعيّنات من تربة المقبرة إلى خارج المخيّم، مقابل مبالغ مالية. وفي أواسط مارس/ آذار 2019، طوّقت القوات الروسية المخيّم، وتكفّلت وسائلها المتطوّرة طوال أسبوع بما عجزت عنه أدوات داعش البدائية، فأرسلت مجموعة من الرفات إلى إسرائيل لتعثر مَخابرُها على رفات زخاريا باومل.
أعلنت إسرائيل (الأحد) أنها استعادت رفات جثّة تسفي فلدمان بعد عملية خاصّة، في مكان ما بسورية (قالت إنه ليس مخيّم اليرموك)، ومن دون تعاون مع السلطات السورية الجديدة، لكن يبدو أن تلك واحدة من العنتريّات الإسرائيلية، على غرار عملية خاصّة مزعومة لاسترجاع ساعة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين من سورية في 2018، اتّضح أن إسرائيل اشترتها من مزاد في الإنترنت.
ينفي المسار الراهن في سورية فرضية العملية الخاصّة، ويرجّح فرضية الصفقة، بعد أن خطّ الرئيس السوري أحمد الشرع مساراً تفاوضياً مع الاحتلال غير مباشر، ويحتاج التقدّم فيه حتى “التوصّل إلى التهدئة” (بحسب وصف الشرع)، تعاوناً أمنياً، وغيره من خدمات. ولعلّ التحقيق مع الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي (واحد من الرعيل القيادي الفلسطيني القديم، الذي بيده مفاتيح ملفّات فلسطينية كثيرة، ناهيك عن تاريخ من علاقات أمنية وثيقة مع النظام البائد) على صلة بالقضية.
وفي ظلّ تخليه عن المحتجزين الإسرائيليين في غزّة لمصلحة استمرار الحرب، فإن نتنياهو أحوج ما يكون لصفقات مع الشرع، تعيد رفات مَن تبقّى من جنوده في سورية، ولم يكن مفاجئاً أن يصرّح مسؤول أمني إسرائيلي بأن اتصالات جرت مع السوريين لإعادة جثّة الجاسوس إيلي كوهين، والمرجّح أن يستمرّ البحث في سورية عن رفات يهودا كاتس وإيلي كوهين (وربّما أرون أراد؟) بصفقات مضمرة ومعلنة.
———————–
حتى يبقى علم الثورة رمزاً يوحّد السوريين/ عبد الباسط سيدا
13 مايو 2025
كانت لحظات مفعمة بالمشاعر الجيّاشة ونحن نشهد علم الثورة والاستقلال يسمو فوق ساريته أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. فهذا العلم يجسّد اليوم ذكرى الملايين من السوريين من الشهداء والمغيّبين وسكّان المخيّمات واللاجئين في الجوار الإقليمي، وسائر الذين ثاروا على سلطة آل الأسد المستبدّة الفاسدة المُفسِدة. كانت لحظات تعانقت فيها البسمة مع الدمعة، وذلك في مشهد يفرض هيبته وجلاله بعد هذا الانتظار كلّه، وتلك التضحيات والتطلّعات. والأمل هو أن يظلّ هذا العلم مرفوعاً ليعبّر عن وحدة السوريين جميعاً، ويمثّل توافقهم، بمعزل عن الانتماءات الفرعية والتوجّهات السياسية، على أساس احترام الخصوصيات والمشاركة المتساوية العادلة في الحقوق والواجبات في سياق الإنماء الوطني العام.
ولعله من المناسب أن نبيّن هنا أن اعتماد هذا العلم ليكون رمزاً للثورة السورية لم يكن بقرار سياسي من المجلس الوطني السوري أو الائتلاف، وفق ما أتذكّر، وإنما كان بناء على شرعية شعبية تجلّت في إرادة السوريين الأحرار، هؤلاء الذين كانوا يقاومون بصدورهم العارية آلة القتل الأسدية والقوى الداعمة لها في أواخر العام الأول من الثورة، التي كانت إلى ذلك الحين تحتفظ بطابعها السلمي، وتجمع بين صفوفها أعداداً هائلة من الشباب من مختلف المكوّنات المجتمعية السورية، إلى جانب المثقّفين والسياسيين والمواطنين السوريين المناهضين لحكم آل الأسد، الذي امتدّ ظلماً وظلاماً 54 عاماً، تحكّم خلالها برقاب وحرّيات السوريين، وتدّخل في أدق تفاصيل حياتهم الشخصية، وضيّق عليهم سبل العيش الكريم بالأساليب كلّها. أمّا لماذا لم يُفكّر في تبنّي علم الاستقلال ليكون رمزاً منذ البدايات، فهو أمر ناجم عن القراءة الخاطئة لمجمل الوضع في ذلك الحين، إذ كان الاعتقاد أن السلطة ستسقط في غضون أشهر، ولذلك لا داعي لفتح باب التباينات أو الخلافات، وإنما ننتظر حتّى يقرر السوريون، في ظلّ عهدهم الجديد، أي علم سيختارون، ليكون رمزاً للثورة والوطن، إلى جانب الرموز الأخرى مثل النشيد الوطني، واسم الجمهورية، ورمز الدولة.
وما أتذكّره بخصوص هذا الموضوع أن الصديق أديب الشيشكلي (حفيد الرئيس الراحل الشيشكلي)، كان يسعى باستمرار من أجل تسويق فكرة اعتماد علم الاستقلال ليكون رمزاً للثورة مقابل علم الوحدة المصرية السورية، وهو العلم الذي اتخذته السلطة الأسدية راية لها بعد زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس. ومن نشاطات الشيشكلي المعروفة في هذا المجال أنه كان يقوم بنفسه بتأمين علم الاستقلال بأشكال وأحجام مختلفة، ويقوم بتوزيعها من خلال الأصدقاء والنشطاء في مختلف المناطق داخل الوطن وبين السوريين في الخارج. وأعتقد أنه لم يكن الوحيد الذي كان يعمل في هذا الاتجاه، ولكنّ دوره كان لافتاً ولا يمكن تجاهله في هذا المجال. ومع الوقت فرض هذا العلم نفسه، بالتزامن مع تجذّر الثورة واتساع نطاقها، وأصبح بتمسّك شعبي، ومن دون قرار رسمي من أي جهة، رمزاً للثورة السورية، وذلك في محاكاة لما حصل مع العلم الليبي القديم الذي أصبح رمزاً للثورة الليبية.
وبمناسبة الحديث عن ليبيا العزيزة وثورتها، أتذكّر في هذا السياق أننا كنا في زيارة إلى طرابلس بعد الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني السوري (2/10/2011)، إذ اجتمعنا مع مصطفى عبد الجليل وعدد من أعضاء المجلس الوطني الليبي الانتقالي. بعد اللقاء تقرّر أن ينقسم وفدنا بين وفدين. الأول اتجه إلى القاهرة للقاء الأمين العام للجامعة العربية؛ في حين تقرّر أن يبقى الثاني في ليبيا، ويستمرّ في اتصالاته مع الإخوة الليبيين، ويشارك في اليوم التالي في احتفالية خاصّة بالثوار الليبيين. وباعتباري كنت وما زلت أرتبط بعلاقة وجدانية مع ليبيا وأهلها، آثرت البقاء فيها علّني أستعيد ذكرى الأيام الجميلة التي عشتها فيها، وأشارك أهلها فرحتهم بالخلاص من الطاغية.
وحينما توجّهنا إلى المكان المحدّد، فوجئنا بأحدهم يسرع نحونا، وهو يحمل العلمين، علم السلطة وعلم الثورة، وهو يسأل ما هو العلم الذي تعتمدونه حتى نرفعه في استقبالكم؟ طبعاً، وقتها كنا نعتمد العلم السوري “الرسمي”، مع وجود توجّه قوي ضمن المجلس لاعتماد علم الاستقلال الذي فرض نفسه من دون قرار رسمي من جانب المجلس كما أسلفت، وذلك وفق ما أعلم وأتذكّر. وظلّ هذا العلم رمزاً يعتزّ به السوريون الثائرون في السرّاء والضراء حتى تخلّصوا من سلطة آل الأسد المافياوية، وجاء اليوم الذي رفعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك ليكون علم الانتصار والأمل والمستقبل الجديد، الذي نتمنّى أن يرتقي إلى مستوى تضحيات وتطلّعات السوريين.
وبمناسبة الحديث عن علم الاستقلال والثورة والجمهورية، أتذكّر هنا أيضاً مشاركة لي في برنامج تلفزيوني قبل نحو عشر سنوات مع أحد السوريين كان يقدّم نفسه من المعارضين، ولكنّه، في الوقت نفسه، كان ينتقد الثورة السورية ومؤسّساتها بأقسى العبارات. وكان محور الحديث هو بيان مؤتمر الرياض الأول الذي جمع بين ممثّلي مختلف أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج عام 2015. لم يتجاوز النقاش بيننا بصورة عامّة حدود الاحترام المتبادل رغم تباين الآراء والمقاربات. ولكن الذي لفت نظري في سياق نقده للسوريين الثائرين قوله: إنهم يرفعون علم الانتداب. وبالمناسبة، لم يكن هو الوحيد من المعارضين القلقين الحائرين صاحب هذا الموقف. وسرعان ما تبيّن لي خلال البرنامج نفسه أن هذا الموقف لم يكن ينمّ عن جهل أو تجاهل فحسب، بل كان يعبّر عن موقف مسبق سلبي من الثورة وأهلها. هذا ما بدا واضحاً حينما وجدته يكرّر التعبير ذاته ثانية وربّما ثالثة. حينئذٍ تدخّلت، وخاطبته بكلّ أدب وهدوء قائلاً: ألاحظ أنك تستخدم كلمة الانتداب ونحن نعلم أن هذا العلم هو علم الاستقلال، علينا أن نحترم مشاعر الناس على الأقلّ، فقد ضحّى آلاف السوريين بأنفسهم دفاعاً عن ثورتهم في ظلّ هذا العلم، ودفاعاً عنه. ولا أعلم ما إذا كان صاحبنا قد أحسّ في تلك اللحظة بخطئه الجسيم، إذ إنه آثر الصمت، ولم يعلّق على ما ذهبت إليه، وربما كان هذا الأمر لصالحه، لأنه أنقذه من الموقف المتسرّع غير الموفّق.
مرّت الثورة السورية بمراحل مختلفة قاسية، وكان القتل غير المسبوق، وتدمير المدن والبلدات والقرى والتهجير وتشريد ملايين السوريين، وتغييب الآلاف، إلى أن تحقّق الحلم المشروع في نهاية المطاف، وسقطت السلطة الباغية، وهرب الابن المريض، ووصلنا إلى اليوم الذي شاهدنا فيه علم الاستقلال والثورة يرتفع علماً للجمهورية فوق سارية المؤسّسة الدولية الأهم في العالم. وحتى يظلّ هذا العلم مرفرفاً بشموخ وكبرياء يجسّد آمال وتطلّعات واعتزاز سائر السوريين، لا بدّ من التعامل مع ما تحقّق من نصر مبين بأنه نصر وطني عام، ساهم فيه السوريون كلّهم، الذين ثاروا ضدّ سلطة آل الأسد، ودفعوا ضريبة الحرية والكرامة والعدالة بسخاء منقطع النظير. ويستوجب هذا خطاباً وطنياً جامعاً يمتلك المصداقية، عبر تعزيزه بالإجراءات الفعلية في الأرض، وليس بمجرّد الأقوال والمجاملات؛ ومثل هذا الخطاب لا بدّ أن يتعارض بالمطلق مع الخطاب الطائفي المقيت، والقومي البغيض، الذي نسمعه هنا وهناك.
تمرّ سورية اليوم بواحدة من أصعب مراحلها، وهي تواجه تحدّيات كبرى، بل وجودية. لذلك، نحن في حاجة ماسّة إلى حوار وطني حقيقي بين ممثّلي المكوّنات المجتمعية والسياسية والإدارة الجديدة، وفي مقدّمتها الرئيس الشرع نفسه. أمّا أن نغضّ النظر عمّا يحصل من ظواهر سلبية، وسلوكيات غريبة، وتحرّك مجموعات مسلّحة تسوّق نفسها باسم الإدارة الجديدة، بينما تتنصّل منها الأخيرة، وما يؤدّي إليه ذلك من ردّات فعل لدى مختلف الأطراف، فهذا معناه أن هناك مخاطر جدّية تهدّد الفرح والطموح السوريين. فما حصل في الساحل، ويمكن أن يحصل مجدّداً. وما حصل في السويداء، ويمكن أن يحصل مجدّداً. وما قد يحصل في المناطق الشرقية والشمالية، وحتى في المناطق الداخلية… ذلك كلّه يُنذر بعواقبَ سيئة لن تكون في مصلحة السوريين، وإنما ستستغلّها القوى المتربّصة، وفي مقدّمتها إسرائيل التي تخطّط وتعمل لتغيير خريطة المنطقة، لتكون وفق ما ينسجم مع حساباتها الآنية والمستقبلية. كما أن النظام الإيراني من ناحيته، ورغم قبوله التفاوض، نتيجة واقعه المأزوم، مع الأميركيين حول الملفّ النووي، وربّما الدور الإقليمي، وإمكانية جذب الاستثمارات الأميركية، لم يتخلَّ بعد عن مشاريعه “التبشيرية” ذات النزعة الإمبراطورية، وهي المشاريع التي يغلّفها بشعارات إسلامية تدّعي نصرة المظلومين، بينما هو يمارس في حقيقة الأمر سياسة استراتيجية التزمها منذ سيطرته على الحكم، وهو ما زال متمسّكاً بها رغم إخفاقاته كلّها. فهو يجد في هذه الشعارات زاداً حيوياً يستمدّ منه الدعم في التسلّط على الدولة والمجتمع والمقدرات الاقتصادية.
لن ينقذ السوريين في مواجهة مختلف أنواع التحدّيات الداخلية والخارجية سوى وحدتهم الوطنية المتماسكة التي تستوجب إعطاء الأولوية لملفّات الحوار الوطني الحقيقي والمصالحة الوطنية الشاملة، والعدالة الانتقالية البعيدة عن نزعات الانتقام الفردية أو الجماعية، إلى جانب التركيز على ملفّ تأمين الخدمات والحاجات الأساسية للمواطنين في سائر أنحاء الجمهورية. حفظ الله سورية وشعبها.
——————————-
عن حاجة سوريا لأبنائها المخلصين/ حسن النيفي
2025.05.13
خلال سنوات مضت من عمر الثورة، حدث أن اضطربت بوصلة المشهد الثوري واكتظ الوسط الإعلامي لمناهضي نظام الأسد بكثير من النقاش الحاد الذي ربما وصل أحياناً إلى درجة الانقسام والاصطفاف في أنساق متباينة في المواقف، ليس لتغيير طال بنية نظام الأسد ولا لتغيّر في قناعات الثائرين بوجهه، بل بسبب دخول لاعبين جدد إلى مسرح الأحداث، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط الأوراق وازدياد الأفق ضباباً قد يحول دون رؤية الأمور كما هي، وإلى أن يصبح الأفق أكثر جلاءً وتتبلور الحقائق، يكون السوريون قد أهدروا مزيداً من الوقت في تلاطم في المواقف، تبيّن فيما بعد أنه كان يمكن تحاشي ذاك التلاطم أو الاستغناء عنه.
اليوم ، وبعد أن انتهى الوسط الثوري السوري من الانتشاء بزهوة النصر، يعود من جديد ليدخل مرحلة أخرى من التلاطم، ليس لأسباب موضوعية ذات صلة بلاعبين جدد أو لأحداث وافدة إلينا من الخارج، بل لعلّة، أو علل، كامنة في دواخلنا، كنّا قد طننّا أنها تلاشت إلى غير رجعة، ولكنّها تباغتنا من جديد، وأظنّ انها سوف تبقى تباغتنا على الدوام طالما ما يزال تفكيرنا وسلوكنا يمضي وفقاً لمنهج ( التهاوش على الصيدة ) وذلك على الرغم من جميع البراقع التي نحاول التلطّي خلفها، وعلى الرغم من امتثالنا الشكلي لجميع الموضات الفكرية والثقافية التي نحاول تقمّصها، وكأن الدم السوري الذي نزف طوال أربع عشرة سنةً لم يقنعنا بأن الأثر الذي خلّفته أرواح السوريين سواء الذين قضوا في مواجهة الطغيان الأسدي على جبهات القتال أو من قضوا في قصف طيرانه أو في البحار أو في أماكن النزوح واللجوء، ما تزال هي الأكثر حضوراً والأقدر على البقاء من شعوذات السياسة ومواربات المنافقين وتخرّصات المؤدلجين الذين لا يريدون حتى الآن مواجهة الحقيقة التي مفادها: (الشعب السوري انتصر وأسقط الطاغية الأسدي).
أن يكون لك رأيك وتحليلك الخاص في مجريات معركة ( ردع العدوان) وتوقيتها والظروف الدولية والإقليمية الموازية لتلك المعركة، وكيف انعكست المتغيّرات في المواقف الدولية، وتبدّل المصالح بشكل إيجابي على القضية السورية، فهذا من شان التفكير السليم والمشروع، ذلك أن الأرض السورية – وخلال أكثر من عقد – كانت مسرحاً لصراع المصالح والاحتراب على النفوذ بين الدول، ثم إن مواجهة السوريين لنظام الأسد لم تكن تجري في فضاء معزول عن العالم، بل كانت المواجهة ضمن بقعة جغرافية هي الأكثر حساسيةً من الناحية الأمنية في الشرق الأوسط، من جهة أنها نواة الأمن والاستقرار في المنطقة، فمن الطبيعي أن يكون أي تغيير نوعي يطول مصيرها مرتبطاً بمصالح الدول النافذة وموازين القوى القائمة على الأرض، أمّا حصافة أصحاب القضية من الفاعلين السياسيين والعسكريين معاً، ورجاحة تفكيرهم والحكمة في التصرّف، فإنما تكمن في القدرة على استثمار ما هو إيجابي في المحيط الإقليمي والدولي واستغلال الفرص التي تتيحها التحوّلات في المصالح والمواقف الدولية، وكذلك استغلال الثغرات ونقاط الضعف لدى العدو، ومن ثم اتخاذ المبادرة في الوقت المناسب، ولعل هذا ما حدث غداة أطاح السوريون بنظام الطاغية الأسدي.
أمّا أنك لا ترى في هزيمة (الأسدية) في سوريا سوى تنفيذٍ أمينٍ لأجندة دولية، وتطبيق فعلي لمخطط قد رسمته الدول، ولم يكن الثوار السوريون سوى أداةٍ تنفيذية فحسب، وتحسب أنك بهذه السردية تستطيع تجريد خصمك الأيديولوجي ( الحاكم ) من ميّزة لا تريدها له، إن كان الأمر كذلك، فهذا ضربٌ من الوهم بل إمعانٌ في السذاجة قبل أن يكون جحوداً أخلاقياً واهتراءً قيمياً، إذ إنك بهذا المنحى من السلوك لا تطول خصمك الذي تتوهّم، بل تتطاول على مُنجَزٍ عظيمٍ لجميع
السوريين، وليس بمقدور أحد ادعاء حيازته وحده، حتى إن الجهة العسكرية التي دخلت قصر الطاغية الهارب لم تدّعِ تفرّدها في هذا المُنجز، ثم إن إقرارك بالنصر، حتى إن كان المُنتصِر خصماً لك، لا يسلبك الحق في الإبقاء على خصومتك، ولا أحد يجبرك على أن تعطيه صكّاً بالبراءة ممّا تراه فيه من مساوىء، ولا أن تمنحه صكّاً بالوطنية التي تظن أنك – وحدك – من تحتكرها، فالإبقاء على الخصومة تجاه طرفٍ ما، انسجاماً مع رؤية سابقة سواء أكانت صحيحة أم خاطئة، أهون بكثير من التطاول على تضحيات شعب جاد بأثمن ما يملك من أجل استعادة حريته وكرامته.
فالذين انطلقوا من الشمال السوري نحو دمشق، مروراً بحلب فحماة فحمص، وسائر المدن والبلدات السورية، هم من أبناء سوريا، من مدنها وبلداتها وقراها ومخيماتها، هم من دخلوا دمشق مُحرّرين، وهم من هزم جيش النظام وقواته، وتقدّمهم بثبات واندفاع فيه كثير من الشجاعة هو من جعل رأس النظام يولّي هارباً منهزماً هزيمةً تليق بمن أجرم بحق السوريين طوال نصف قرن.
أمّا امتناع الروس والأميركان عن استهداف قوات ( ردع العدوان ) وعدم التعرّض لها نتيجة لتبدّل المواقف والمصالح، فهذا لا ينتقص من مشروعية الثورة السورية ولا يطول عدالتها بسوء، ولا يقلّل من شان انتصارها، إذْ ليس العار حين تتخلّى الدول عن مناصرة نظام مجرم أوغل بدم شعب كامل، بل العار، كلّ العار على الدول التي أسهمت بقتل السوريين طوال أربع عشرة سنة، سواء بفعل مباشر كروسيا وإيران، أو من خلال صمتها وتجاهلها لجرائم النظام البائد ، كبقية الدول الكبرى الأخرى، فهل كان ينبغي علينا أن نتوجّه بالشكر إلى من كان يقتلنا طوال أكثر من عقد، لأن مصالحه اقتضت التوقف عن قتلنا؟ وبالتالي هل كان على الشعب السوري أن يهدي نصره العظيم إلى روسيا وأميركا، لأن الأولى تكرّمت برفع الوصاية عن نظام الأسد، والثانية لأنها ملّت من الرهان على تغيير سلوك الأسد طوال السنوات السابقة وأيقنت بضرورة أو جدوى زواله؟.
أنْ تكون معارضاً للسلطة الحاكمة، فهذا حقك الذي لا ينازعك فيه أحد، وأن تكون دائم الانتقاد لسلوك السلطة فهذا واجبك الأخلاقي وليس السياسي فحسب، لكن شريطة أن تستلهم ضميرك وصدقك من حيث الوقائع الدّالة وليس اللجوء إلى المبالغات واختلاق وقائع لا وجود لها أو تزييفها بهدف التجييش والتحريض، فالمبالغة وتحييد الحقائق هي إهانة للحق و للضحية قبل أن تكون انتصاراً على الخصم. وأنْ تجهرَ بكرهك للحاكم – شكله أو طباعه أو سلوكه الحياتي الشخصي – فهذا كشأن الآخر حين يُعجَب بما تكرهه ولا دخل لجميع ذلك بمكانته الاعتبارية، فالحاكم، أيّاً كان منصبه، ينبغي أن يكون في سوريا الجديدة موظفاً، إن أحْسنَ فهذا واجبه ولا منّةَ له على أحد، وإنْ أساء فتنبغي مساءلته.
أن تسعى أو تدعو إلى تغيير نظام الحكم، فهذا حقك، لكن شريطة أن يكون مسعاك أو دعوتك مقرونة بحاجة للصالح العام من جهة، وكذلك شريطة أن يشاطرك هذه الحاجة قطّاع واسع من الشعب، باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير، إن جميع دواخلك الأيديولوجية والسياسية والثقافية تصبح شأناً عامّاً إن استطعتَ أن تجعلها جزءاً من قناعات الناس، أمّا الاستمرار في تصيّد الوقائع بغية إعادة إنتاجها وفقاً لما تشتهيه مُتَوهِّماً أنه سيغدو صواباً في قناعات الآخرين، فهذه سمة المفلسين الذين لا يملكون سوى الرهان على فشل الخصم.
سوريا اليوم بلد شديد النزف، محطّم، مسكون بكل أشكال البؤس، شعبها موجعٌ حدّ الإنهاك، وكما أنّها بحاجة إلى حكّامٍ مخلصين ومتفانين للنهوض بها، كذلك هي بحاجة إلى معارضين مخلصين غيورين على مصالح شعبهم، وبتعزيز حضور ودور هذا الصنف من المخلصين ( من الحكّام والمعارضة معا) يمكننا تجاوز الثنائية القاتلة: ( مُطبّلين – حاقدين مُحرّضين).
تلفزيون سوريا
———————
إدارة الصراع على الجغرافيا السورية/ عدنان عبد الرزاق
12 مايو 2025
سمعت خبيراً اقتصادياً مرة يقول: لو استغلت سورية نعمة الجغرافيا فقط، لتحسّنت معيشة شعبها إلى أكثر من بحبوحة سكان الخليج، وأذكر كيف بيّن ذلك الخبير دور موقع سورية بعبور خطوط الطاقة والعائدات التي ستجنيها، وكيف شرح تطوير “صناعة الخدمات” جراء العبور فوق الأرض السورية وتحتها، بما يلغي البطالة في سورية و”ينام السوريون إلى ما بعد الظهر”.
اليوم، وبعد هروب الأسد وتعطيل تلك الأحلام، أعيد، وإن بالخفاء أحياناً، طرح جملة من المشاريع المتوقفة والمؤجلة، داخل سورية ودول جوارها، لتسرّع رفع العقوبات الأوروأميركية، أو تخفيفها، من تحويل الأحلام إلى واقع، وإن بحسابات جديدة وتحالفات مختلفة تعتمد توزيع الحصص والأدوار، وفق مبدأ الأولوية لواشنطن ومن ثم لحلفائها.
والذي يقدر نعمة الجغرافيا السورية، فضلاً عن الثروات المدفونة داخل البلاد والمشروعات المعطلة، يعرف ربما كم تتلهف تركيا إلى الاستفادة من الوصول إلى الدول العربية عبر سورية، ويتفهم دور منفذ لبنان البري الوحيد وأهمية وصول دول آسيا براً، إلى تركيا وأوروبا، عبر الممر البري شبه الوحيد الكامن بسورية.
ونعرف مخاوف روسيا وإيران وإسرائيل، إن توسعنا لما هو استراتيجي وطاقوي، فسورية الحلم المؤجل لعديد من الدول المنتجة للنفط والغاز لإيصال صادراتهم إلى أوروبا، عبرها. طبعاً من دون المبالغة بموقعها واعتبارها همزة الوصل الوحيدة بين طرق عبور الغاز، أو أنها طريق مسدود، ولا عبور لخطوط النفط إلى أوروبا عبر المتوسط أو تركيا إلا من خلالها، فثمة شمالي العراق وإيران بالمعادلة، وإن كانا، ليسا كما الميزة السورية الجغرافية وانخفاض التكاليف… وربما الأهم، الشاطئ المتوسطي الذي يعطي تفضيلاً للحالة السورية.
قصارى القول: باستعراض لمشاريع خطوط الطاقة العابرة من سورية والصراع على “الجيوبوليتيك السورية” الذي تجلّى فاقعاً بعد استقلالها، عام 1946، وقت رفض الرئيس، شكري القوتلي، خطة مشروع “التابلاين” الذي أمر به الملك السعودي، عبد العزيز آل سعود باقتراح أميركي، لنقل نفط السعودية والخليج إلى لبنان عبر سورية ومن ثم إلى العالم عبر المتوسط، وما يقال إنه سبب إطاحة القوتلي وتسهيل وصول الرئيس، حسني الزعيم، الموالي للولايات المتحدة ومشروع “التابلاين”، الذي نفَّذته لاحقاً عام 1950.
سنرى، جراء الاستعراض، أن سورية يمر عبرها الخط العربي لنقل الغاز الذي بدأ عام 2001 بين مصر والأردن وسورية ولبنان، لتتعدى أهميته وفوائده المنطقة، وتطاول أوروبا وآسيا وأفريقيا، بعد التفاهمات الإقليمية ووصول الغاز العربي إلى حدود تركيا وربطه بخط أنابيب نابوكو.
وتجلى هذا الخط واقعاً، بعد تنفيذ مراحله الثلاث، من حقل العريش المصري للعقبة إلى الأردن عام 2003، ثم قسم من العقبة إلى الرحاب قرب الحدود السورية عام 2005، والقسم الثالث، عام 2008، من الرحاب إلى حمص وسط سورية، قبل أن يبلغ الحلم منتهاه عام 2009 ويصل الخط من حمص إلى ميناء بانياس غربي سورية وطرابلس شمالي لبنان.
لكن هذا الخط العربي توقف بعد الثورة السورية، وتأذت بعض خطوطه التي يقع نصفها ضمن الأراضي السورية، ولم يزل معطلاً حتى بعد استقرار سورية خلال الأعوام الأخيرة، رغم تصريحات أميركية بإعفاء إعادة إحياء المشروع من عقوبات “قانون قيصر” لما له من دور في خنق الغاز الروسي والإيراني.
والخط الثاني الذي عطله نظام الأسد السابق بطلب إيراني، هو خط الغاز القطري – التركي، بعد اقتراح الدوحة عام 2000، بناء خط أنابيب غاز طبيعي بقيمة 10 مليارات وطول 1500 كيلومتر عبر السعودية والأردن وسورية، قبل أن يتفرع من جنوبي سورية، إلى طرابلس شمالي لبنان وإلى اللاذقية غربي سورية وإلى تركيا، لربط قطر مباشرة بأسواق الطاقة الأوروبية.
بيد أن نظام الأسد، ورغم ما يحققه الخط من عائدات مالية مباشرة وحصة من الغاز، رفض عام 2009 بطلب إيراني ثم روسي، السماح لخط الأنابيب بالمرور عبر سورية، مما أدى إلى فشل المشروع، رغم الإغراء لنظام الأسد وقتذاك، والتعويل الأميركي والأوروبي على الخط الذي يعزز أمن الطاقة بأوروبا، ويحد من نفوذ روسيا وتحكمها في طاقة القارة العجوز التي تمدها موسكو بنحو 70% من صادراتها الغازية.
وثالث الخطوط لنقل الطاقة التي تمر، أو كانت ستمر عبر الجغرافيا السورية، هو خط الغاز “الإسلامي” الإيراني، ذلك الحلم الذي يراه مراقبون سبباً لتكالب طهران على التمركز في الأرض السورية خلال الثورة ومحاولة قتلها حلم السوريين.
لأن إيران ومن خلال حلمها أن تكون مورد الطاقة الرئيس لأوروبا، سعت لتنفيذ “الخط الإسلامي” من حقول الغاز على الخليج العربي مروراً بالأراضي العراقية، وصولاً إلى البادية السورية بريف حمص الشرقي، قبل أن يتفرع إلى موانئ لبنان وإلى الشمال ليصل إلى تركيا.
علماً أن “خط الأنابيب الإسلامي” يمتد من الجانب الإيراني من حقل الغاز الإيراني في الخليج العربي مروراً بالعراق عبر سورية ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع من حمص إلى اللاذقية ومن حمص إلى الشمال نحو تركيا ومن حمص إلى موانئ لبنان. لكن هذا المشروع لم ير النور أيضاً، بسبب الثورة السورية وفشل إيران في السيطرة على الأراضي السورية، قبل أن ينشب الخلاف بين طهران والأسد في العام الأخير قبل هروبه، لأسباب كثيرة، منها التقارب العربي مع الأسد ورفض موسكو التي ستتضرر من “الخط الإسلامي” ويحد من تحكمها في الطاقة الأوروبية.
وآخر الخطوط التي كانت قائمة وتعطلت، فهو خط كركوك – بانياس، المقام منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، بطول 800 كلم وطاقة 300 ألف برميل يومياً، والذي على ما يبدو، سيكون الأول إعادة وتفعيلاً، بعد المساعي العراقية وزيارة الوفد العراقي دمشق أخيراً، لبحث إعادة تأهيل الخط وتصدير الخام العراقي الذي يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يومياً، عبر موانئ سورية إلى الأسواق العالمية، لأنه الأقل كلفة ومخاطر من خط جيهان التركي الذي يتأثر بالتوترات مع حكومة إقليم كردستان واضطرابات البحر الأحمر جراء التصدير عبر موانئ البصرة.
بيد أن الخط، بواقعه الراهن، يحتاج إلى تأهيل وإصلاح وصيانة كبيرة، ربما ما يقارب تكاليف مد خط جديد، أو الالتفاف على المقاطع المهترئة والمتفجرة والمهملة منذ آخر توقف للخط عام 2003. للوصول إلى ميناء بانياس، أو، وهذا ليس بالبعيد، ربما تلتف العراق على المشروع برمته، وتتجه إلى ميناء العقبة، رغم تضاعف المسافة وزيادة التكاليف لتكون خسارة النقل وبناء الخط مع الأردن على العراق، وخسارة على سورية جراء تفويت تشغيل مصفاة بانياس وتنشيط المرفأ وموارد ونسبة من النفط، وهي من تستورد بنحو 1.2 مليار دولار نفط خام سنوياً، بعد تراجع إنتاجها من 380 ألف برميل قبل الثورة إلى نحو 30 ألف برميل تسيطر عليها دمشق اليوم.
قمة إسطنبول تعد سورية بحلّ أزمة الكهرباء
نهاية القول: ليس من المبالغة بمكان، إن قلنا إن الجغرافيا السورية، نعمة ونقمة في آن، بل نسب جلّ التكالب على أرضها التي تعتبر ممراً شبه إلزامي، لخطوط الغاز والمعابر والطرق التجارية الدولية. فالجغرافيا أحد أسباب منع انتصار الثورة، أو تأخيره على الأقل، بعد صراع المتنافسين في موسكو وأنقرة وطهران والخليج وحتى الولايات المتحدة، التي ركزت قواتها على مثلث سورية العراق الأردن، منذ سنوات، لتعيق أي مشروع نقل الطاقة.
كما أن الجغرافيا، اليوم، يمكن أن تكون نعمة على السوريين وعاملاً أساساً في تقليل البطالة وتأمين الطاقة، بل المساهمة بإعادة إعمار البلاد من دون مد اليد والارتهان لإملاءات الدول وشروط المؤسسات المالية. ليبقى الحسم، بين النعمة والنقمة، في لعبة المصالح وإدارة وحسن استثمار الصراع على الجغرافيا، وتصدرهما أولويات عمل حكومة الرئيس أحمد الشرع اليوم، والتي، بالإدارة والاستثمار، يمكن أن تنقل سورية من الفقر والعوز إلى الغنى والبحبوحة… أو تعيدها منطقة ساخنة يتصارع عليها أصحاب المصالح.
————————
مأزق السلطة في سورية الجديدة/ مرتضى مهند
10 مايو 2025
يُعاني المشهد السوري اليوم من انزلاق مُتسارع نحو إعادة إنتاج الطائفية، ولكن هذه المرّة على نحو معكوس. فبينما كانت الطائفية السياسية سابقًا أداة تمكين للأقلية العلوية في مفاصل الدولة والنظام، تتخذ اليوم ملامحها الجديدة شكل تماهٍ سني مع الدولة، بوصفها مكسبًا انتقاليًا بعد سنوات طويلة من الإقصاء والعنف. غير أنّ هذا التغيير في الهوية السياسية لا يصاحبه تغيير في بنية الدولة أو منطق الحكم، ما يجعل من الدولة السورية المعاصرة كيانًا هشًّا، يُعيد إنتاج التصدّع، بدلًا من معالجته.
التصوّرات، كما يشير علم النفس السياسي، لا تقلّ أهمية عن الوقائع؛ بل تتفوّق عليها أحيانًا في توجيه السلوك. فالمجتمعات لا تتفاعل مع الواقع كما هو، بل كما تتصوّره. وفي الحالة السورية، تشكّل لدى قطاعات واسعة من المسلمين السنّة تصوّرٌ عميق بأنّ ما جرى منذ عام 2011 ليس فقط قمعًا لثورة شعبية، بل استهدافًا طائفيًا مُمنهجًا، مارسه نظامٌ مُنحاز لأقلّية مذهبية، واستقوى بصمتٍ أو تأييدٍ من أقليات أخرى. هذا التصوّر غذّته وقائع ميدانية دامغة، لكنه سرعان ما تحوّل لدى البعض إلى بوصلة تفسير مطلقة، تقرأ كلّ شيء من منظور طائفي صرف.
لقد أنتج هذا التصوّر مشاعر عدائية تجاه الأقليات، وولد استبطانًا لثنائية ظالِم (علوي/أقلي) ومظلوم (سني/أكثري)، لا تترك مجالًا لتصوّر وطني جامع. ومع تراجع المدّ الثوري وارتفاع وتيرة العنف الأسدي، تعزّز حضور هذه الثنائية في الإعلام والمعارضة والمجتمع، حتى بات تبرير الانتقام، أو تقبّل العنف المضاد، أمرًا شائعًا، حتى في أوساط من يُفترض أنهم حداثيون أو لادينيون.
اللافت أنّ هذا التصوّر الطائفي لم يعد مقتصرًا على النظرة إلى الماضي، بل بدأ يوجّه الحاضر ويصوغ المواقف من السلطة الجديدة في دمشق. ففي لحظةٍ يُفترض أنها انتقالية، تتحوّل الدولة من مشروع عمومي إلى ملكية طائفية مضادة. هذا ما يجعل بعض السنة يتماهى مع الدولة الجديدة على نحو يشبه تمسّك العلويين بـ”دولتهم” السابقة. في الحالتين، الدولة أداة للخوف، لا للتعايش. هذا الانقلاب في الهوية لا يعني بالضرورة تحوّلًا في البنية؛ إذ لا تزال مؤسسات الدولة تفتقر إلى مبدأ المواطنة، وتُدار بمنطق العصبية والولاء الطائفي.
من جهةٍ أخرى، يعاني النظام الجديد من مفارقة حادة؛ السنة، وإن كانوا أكثرية عددية، لا يمتلكون التمكين السياسي الذي امتلكه العلويون سابقًا (من باب أن العلويين حكموا لـ40 عامًا). فالأكثرية، بطبيعتها، أكثر تنوّعًا وتعدّدية، وأقلّ قابلية للتماهي الصلب مع السلطة. كما أن ّالخوف الذي يسكن الوعي السني حيال “العدو الأسدي” لا يرقى إلى الخوف الوجودي الذي شحن العصبية العلوية في العقود الماضية. لذا، يصعب على النظام الجديد أن يستنسخ تجربة الأسد الطائفية على المدى البعيد.
الإشكال أنّ هذه التصوّرات المُتبادلة تُنتج أشكالًا من الصراع الذاتي تشبه “أمراض المناعة الذاتية” في الجسد البشري؛ حيث تنقلب آليات الحماية إلى أدوات فتّاكة. فكما استُخدم خطاب حماية الدولة سابقًا لتبرير المجازر، يُستخدم اليوم لتسويغ العنف المضاد، وكأنّ الدولة مجرّد ذريعة لتصفية حسابات مذهبية مؤجلة.
النتيجة أنّ أيّ نظام سياسي جديد في سورية لن يستطيع الاستقرار ما لم يُدرك خطورة الطائفية، ويواجهها بجرأة لا بمجرّد خطابات. المطلوب ليس توازنًا طائفيًا، بل إعادة تأسيس للدولة على أساس المواطنة، بما يتيح لجميع المكونات التماهي مع الدولة، لا الخوف منها أو الاحتماء بها.
ختامًا، فإنّ إعادة إنتاج السلطة على أسس طائفية مقلوبة، مع الإبقاء على منطق الإقصاء والتخوين والعنف، لن تقود إلا إلى دورة صراع جديدة. وحده تفكيك التصوّرات الطائفية، وبناء تصوّر وطني جامع، قادر على منح سورية استقرارًا حقيقيًا، بعيدًا عن هويات القلق وثنائيات الضحية والجلاد.
————————-
التلاعب بالبديهيات/ سلوى زكزك
11 مايو 2025
في ظل النزاع الحاد بالسرديات الضمنية والمعلنة الذي يأخذ طابعًا رسميًا أو حكوميًا بين سلطة وشعب بمكوناته المختلفة، لا يمكن تجاهل الخطاب الشعبي الجاد والمسؤول الذي يحاول تطويق الشرر المشتعل أو التخفيف منه في أحسن الأحوال.
على الرغم من جدية وإيجابية مساعي دعاة الخطاب التوفيقي بين الناس الواقعين ضمن الاستقطابات الحادة، يتسم هذا الخطاب بالانفعالية والالتفاف على العبارات والألفاظ ومحاولة التنصل من الاتهامات، بل يتم السعي إلى رأب الصدع بين الأطراف المحتدة، والتي تستعين بفائض القوة لتواجه الآخر باعتاره متهمًا وليس شريكًا.
تبدو واضحةً محاولات التبرير المكررة التي تسبق كل نقد، كما لا يمكن إنكار المقدمات والاعترافات المسبقة التي تتكامل لتقدم صورة قادرة على أن تغفر لكل راغب بالنقد تجرؤه على النقد، أو حتى تجرؤه على تقديم خلاصات مختلفة، أو تصورات مستقبلية مختلفة، لذلك تبدو كل المحاولات الناقدة متلعثمة لغويًا، وقاصرة سياسيًا، ومنفعلة تفاعليًا.
إن السعي لتقديم شهادات البراءة الثورية، أو للترويج لتاريخ شخصي أو عائلي تقاطعي يقف بنفس المسافة بين الجميع سابقًا وحاليًا ولاحقًا، يوحي تمامًا بانعدام فرص تقبّل الرأي المختلف أو تقبّل الآراء النقدية الملحة لمواجهة تمترس فوقي يقدم نفسه أغلبيةً غير محققة فعليًا إلا بوصولها وتحكمها بالسلطة الحالية.
ماذا يعني أن نشكر شريكًا طبيعيًا في الوطن فقط لأنه من الأغلبية حسب ما يحاولون تعميمه، فقط لأنه تضامن مع ضحية من أقلية حسب توصيفهم لخريطة الانتماءات المستحدثة أو المتلاعب بها بهدف التشكيك فيها وبكل مساعيها الطبيعية للاندماج في واقع وطني عام؟
تقضي البديهيات بأن يتضامن البشر مع بعضهم في الملمات والحوادث، والأحرى أن نشهد تضامنًا وطنيًا لأنه سكة السلامة الوحيدة. المشكلة هي في اعتبار الفترات الانتقالية مسارات انتقامية وتغير في خريطة الانتماءات وفي خريطة الواجبات الوطنية البديهية.
ماذا يعني أن تنهض فجأة السرديات التاريخية لعائلات ومجموعات ومكونات بكاملها لتؤكد أنها جزء من النسيج الوطني العام! لماذا التأكيد هنا؟ الدستور وما يفرزه من قوانين وطنية هي الفيصل الوحيد الضامن والمسؤول، وليس السرديات المحمومة الساعية لإثبات أن أصحابها تاريخيًا كانوا هنا مع الجميع، وما زالوا حاضرين أيضًا بإرادة العيش المشترك والانتماء الطبيعي والوطني.
ما جدوى وقوعهم في وضع يترجون فيه موافقة ورضا الجميع، وكأنه حق محصور بموافقة الأغلبية غير دقيقة التوصيف! منذ متى وماذا يعني أن يشعر الشخص أو جماعة محددة بضرورة إثبات انتمائهم عبر ترجي التعاطف وتسوّل القبول العام؟ إنها واقعية محبطة، لكنها خطيرة وتؤكد اهتزاز الهوية الوطنية الجامعة، واهتزازها لا يعني فقط اهتزاز الأمن الشخصي للأفراد ولا تغييب الاعتراف العلني والقانوني، بل يعني أن هذا الاعتراف كان موجودًا بمنطق محسوب على الغلبة السابقة! وكأن كل العهود هي تبادل لمواقع الغلبة!
أي اهتزاز هذا الذي ينسف أمان فئات معينة وحاضرها ومستقبلها وكأن المطلوب ليس فقط الولاء، بل إبداء كل تفاصيل الولاء وأولها الصمت والإذعان والموافقة على تغييب السرديات الوطنية السابقة والسعي لتعميم سردية واحدة، خارج الخريطة الوطنية العامة، وخارج الحق والواجب في التشاركية، وخارج الحقوق الطبيعية البديهية.
من الضروري جدًا لملمة الخريطة الوطنية، ووقف أي خطر يهدد الآخرين المتهمين أو المستبعدين حاليًا، كي لا يضطروا لإعادة ترتيب أولوياتهم في محاولتهم للحماية عبر الانغلاق أو الاستنكاف عن المشهد العام.
تكمن آليات التشاركية في الحفاظ على البديهيات الوطنية بتحديد معنى الأغلبية التي حتى لو كانت عددية فقط! ما مدى فعاليتها؟ ما مدى انفتاحها على المرحلة الانتقالية ووجوه السلطة الجديدة؟ إن قراءة متأنية وواقعية وبديهية تُسقط توصيف الأغلبية العددية قوةً فاعلةً ومركزيةً، بسبب أن الأغلبية الفعلية هي الأغلبية الصامتة التي خرجت عن دائرة الفعل سابقًا وحاليًا، فقط لأنها لا تمتلك المواطنية البديهية المستحقة، التي يجرى التلاعب بها دومًا وبتواطؤ إقصائي لا وطني.
العربي الجديد
———————-
أوقاف العلم السورية… يا للفرصة/ محمد أمير ناشر النعم
13 مايو 2025
كنّا طلاباً في المدرسة الخسروية منتصف الثمانينيات من القرن الماضي نأخذ راتبا شهريا من المدرسة مقداره 125 ليرة سورية مراعاة لشرط الواقف، وكنّا، نحن الطلاب، نتحدّث في ما بيننا بأنّ هذا الراتب لا يمثل إلا عشر ما نستحقه أو أقل من ذلك، وأنّ الدولة لو حافظت على أوقاف هذه المدرسة واستثمرتها استثماراً صحيحاً، ولو أنّها راعت شرط الواقف بدقة لأغنت الطلاب والمدرسين ولَعاشوا في رغد وغضارة، وكنّا نقرأ في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب للشيخ كامل الغزي عن وقفية هذه المدرسة وأوقافها: بساتين ومزارع وطواحين وإصطبلات ودكاكين وخانات في عينتاب وأنطاكية ومنبج وحارم وأعزار والجبول وجبل سمعان وحلب، ويكفي أن نعرف أنّ الخان الكبير الهائل خان الشونة الملاصق للمدرسة والمطل مباشرة على قلعة حلب كان من جملة أوقاف هذه المدرسة.
على مدار التاريخ الإسلامي لبّت مؤسسة الوقف الإسلامية الحاجات الروحية والمادية لأفراد المجتمع، وكان الوقف ثلاثة أنواع: الخيري الذي يخصِّص الواقف ممتلكاته لمؤسسة دينية أو مدنية خيرية. الذُّري (الأهلي) الذي يخصِّص صاحبه ممتلكاته لأبنائه وذريته، وعند انقراض السلالة تنتقل ملكية الموقوف إلى مؤسَّسة دينية أو مدنية خيرية يحدّدها الواقف، وكان من جملة أهداف هذا النوع من الوقف الحفاظ على الأراضي والعقارات من التقسيم والتجزئة إلى حصص صغيرة ومعقّدة يسهل استيلاء الحكّام أو الجشعين عليها، إذا قُسّمت وفق أنصبة الميراث. المشترك الذي يجمع بين الوقف الخيري والذري.
عدّد الشيخ مصطفى السباعي في كتابه من روائع حضارتنا قرابة 30 نوعاً من أنواع المؤسسات الخيرية التي أقامتها الأوقاف الإسلامية، كالمساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات والخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين والتكايا والزوايا، التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله، والسقايات، أي: تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعاً، والمطاعم الشعبية التي تقدّم الطعام للفقراء، وكانت حتى عهد قريب من القرن الماضي تُقدِّم ذلك في تكية السلطان سليم، وتكية الشيخ محيي الدين بن العربي، وحفر الآبار في الفَلَوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، وتمويل صناعة السلاح، ودعم الثغور في المناطق الحدودية التي تشهد مناوشات دائمة مع الجار العدو، وكانت بعض الأوقاف تُخصّص لتكون مقابر فيتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة وغيرها الكثير.
وتوسّعت دائرة اهتمام المؤسسات الوقفية لتشمل الحيوان، فكان هنالك أوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة، وأوقاف لرعي الحيوانات المسنّة العاجزة، ومن أوقاف دمشق وقف القطط تأكل منه وترعى وتنام، حتى لقد كان يجتمع في دارها المخصصة لها مئات القطط الفارهة السمينة التي يُقدّم لها الطعام كل يوم وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة والنزهة، وكذلك اشتُهر في حلب جامع ومدرسة العثمانية بوصفه مأوى للقطط المشرّدة، فكانت تلقى العناية ويُقدّم لها الطعام بانتظام. أما أطرف مؤسّسات الوقف الخيرية فوقف الأواني الذي خصصه أحد الأعيان في زمن المماليك للأولاد والخدم الذين يكسرون الأواني وهم في طريقهم للبيت، فيأتون إلى هذه المؤسسة، ليأخذوا أواني جديدة بدلاً من المكسورة، حتى لا ينالهم التعنيف أو يخالطهم الإحراج. كذلك نقرأ عن وقف النساء الغاضبات الذي كان يقدّم المأوى للمرأة التي تختلف مع زوجها، فيطلقها أو يهجرها، فتترك البيت وليس لها سكن تأوي إليه، فكان هذا الوقف يؤمّن لها المبيت والطعام والنفقة إلى أن تتزوج، أو تهدأ عاصفة الاختلاف بينها وبين زوجها، فترجع إلى منزل الزوجية.
ومنذ انهيار الدولة العثمانية ودخول سورية في مرحلة الاستعمار الفرنسي، ثم وغولها بعد عدة سنوات في مرحلة الاستعمار الأسدي كانت هنالك خطة ممنهجة غير معلنة، بقدر الوسع والطاقة، لتعطيل مؤسسة (الأوقاف)، وتفريغها من كل مضمون خيري، ومحاولة إبطائها إلى درجة الجمود، وإيقافها إلى حدّ الهمود.
وبدأت فكرة تقويض الأوقاف تقويضاً مقصوداً وواعياً منذ بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 حين أحبطت مؤسسة الأوقاف محاولات المستعمرين الفرنسيين شراء الأراضي الجزائرية مراراً وتكراراً، لأن أكثرها كانت أوقافاً إسلامية، ولذلك لم يكن من الممكن قانوناً نقل ملكياتها إلى هؤلاء المستعمرين، ومن أجل هذا السبب ومن أجل أسباب أخرى ليس هنا محل تفصيلها بدأ سعي الإدارة الاستعمارية للسيطرة على مؤسسة الوقف بسلسلة من التشريعات، وساعدها في ذلك مستشرقون فرنسيون شنّوا حملات لتشويه سمعة المؤسسة بين الجزائريين أنفسهم، ونحيل هنا إلى دراسة ديفيد باورز باللغة الإنكليزية: Orientalism, Colonialism, and Legal History: The Attack on MuslimFamily Endowments in Algeria and India.
انتقل هذا التأثير إلى سورية في عهد السياسة التغريبية للاستعمار الفرنسي، ويحدثنا فيليب خوري في كتابه سوريا والانتداب الفرنسي سياسة القومية العربية 1920 – 1945 قائلاً: “عانى الزعماء الدينيون المزيد من الإذلال على أيدي الفرنسيين الذين حاولوا كدولة مسيحية أن يفرضوا إشرافهم المباشر على مؤسسات دينية كالأوقاف التي غالباً ما كانت تقدّم جزءاً رئيسياً من مداخيلهم”، ويؤكد ذلك إدموند رباط في كتابه تطور سورية في ظل الانتداب عندما يناقش سياسات الانتداب الفرنسي في سورية، ومحاولات السيطرة على المؤسسات الدينية، مشيراً إلى أن الإدارة الفرنسية سعت إلى تقليص دور العلماء والمشايخ من خلال التحكم في مصادر تمويلهم، مثل الأوقاف.
أما الأثر الأبرز لهذه السياسة التغريبية فنراه في المرسومين التشريعيين رقم 76 و128 اللذين أصدرهما الانقلابي حسني الزعيم سنة 1949، ونُسبا إليه، وكان الأدق نسبتهما إلى وزير العدل أسعد الكوراني الذي كتب في مذكراته: “وكان إصدار هذه القوانين باقتراحي، وموضوعة من لجان كنت أرأسها فعلاً”.
كان هناك خلل بيّن في إدارة الأوقاف في تلك الآونة، ولكن بدلاً من الإصلاح كان الإلغاء والعلاج بالكي بل بالكرباج، فألغى المرسوم الأول الوقفين، الذُّري والمشترك، وأناط بمديرية الأوقاف العامة وفروعها في المحافظات إدارة عقارات هذه الأوقاف وبيعها واستثمارها. وأنهى المرسوم الثاني ولاية المتولّين على الأوقاف، وكلّف مديرية الأوقاف العامة إدارة الأوقاف الإسلامية على الصورة التي تحقق مصالح المسلمين من دون التقيّد بشرط الواقف ضارباً بذلك القاعدة الراسخة والصخرة الصلبة التي قام عليها بنيان الأوقاف الهائل: “شرط الواقف نصّ الشارع”، والتي تعني أن ما يوصي به صاحب الوقف له قوة التشريع، فهو صاحب الملك، وله وحده أن يقرّر في ما سينفق عائد ملكه. ثم توالت المراسيم الجائرة المتلاعبة المنتهكة في فترة حكم جمال عبد الناصر إبّان الوحدة مع مصر 1858 – 1961، ثم في فترة حكم الطغمة البعثية ثم الأسدية.
مائة سنة كاملة وهذه المؤسسة العظيمة في حالة موت بعد أن كانت إحدى أهم المحرّكات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية والتعليمية والدينية أصلاً وأساساً. وفي هذه الأثناء، وخلال هذه المائة سنة المنصرمة كانت الأمم الأخرى تطوّر أوقافها، وتستفيد منها استفادة تفوق كل تصوّر خلَّاق أو خيال مجنّح، وأقرب مثال لذلك أشهر الجامعات الأميركية التي نهضت وقامت واستمرت وتطوّرت من خلال الأوقاف، كجامعة هارفارد وييل وستانفورد وميشيغن وكولومبيا وماساتشوستس ونورث وسترن.
مقاربة تاريخية وواقعية من التجربة الألمانية
وكما أنّ الأوقاف الإسلامية في سورية تعرّضت للاستيلاء والتغوّل، فقد تعرّضت الأوقاف المسيحية في ألمانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى استيلاء الدولة الألمانية عليها، وعندما خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى مهزومة منكسرة أرادت أن تجمع شتاتها وتعيد بنيان نفسها بنياناً راسخاً، فأقامت جمهورية فايمار، وكتبت دستوراً حديثاً سنة 1919 لم تشهد ألمانيا في تاريخها مثيلاً له، واعتُبر وقتها من أفضل الدساتير في العالم. ألغى هذا الدستور نظام الكنيسة الحكومية الساري حتى ذلك الحين الذي كان بموجبه حاكم الدولة هو حامل السلطة الحكومية في كنيسة الدولة البروتستانتية، أي: لم تعد هناك كنيسة للدولة، وأكّد الدستور حرية الدين والضمير مستنداً في ذلك إلى فلسفة التنوير الكانطية والليبرالية القانونية، ولكنه لم يغفل عن تجاوز الحيف الذي وقع على ممتلكات الكنيسة، فقرّر تعويضها بما سمّي في الدستور نفسه بـ Staatsleistungen (معونات الدولة)، ضمن اتفاق أُبرم بين الدولة والكنيسة (البروتستانتية/ الكاثوليكية) تُقدّم الدولة بموجبه للكنيسة التزامات مالية سنوية تعويضاً عن عمليات المصادرة الكبرى التي حدثت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للعقارات والممتلكات التي كانت الكنائس تستخدمها في السابق، وتُقدَّم هذه المعونات تلبيةً لحاجات الكنيسة المادية وفقاً لتقدير الكنيسة نفسها، وليس وفقاً لتقدير الدولة، وقد أكّدت هذه الاتفاقات الدستورية المبرمة أنّ هذه المعونات ليست طوعية من الدولة، بل التزامات تاريخية لا يمكن إلغاؤها إلا في مقابل تعويض مناسب، ومنذ مائة سنة ونيف حتى اليوم ما زالت ألمانيا تدفع مبلغاً سنوياً هائلاً على سبيل التعويض، وهو في السنوات الأخيرة يفوق الـ 500 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى ما تقتطعه الكنيسة من ضريبة مالية من الدخل الشهري للمواطنين الألمان المنتسبين إليها: 8% في ولايتي بايرن وبادن ــ فورتمبيرغ، و9% في بقية الولايات البالغ عددها 14 ولاية، وبدءاً من سنة 2025 أُعفي مَنْ دخله أقل من 12 ألف يورو في السنة من هذه الضريبة.
وبهذه المعونات والضرائب، علاوةً على التبرعات ومساهمات الأفراد ومِنَح المؤسسات أُتيح للكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية أن تستمرا في تمويل أكبر جمعيتين أو منظمتين في البلاد: جمعية الدياكوني التابعة للكنيسة البروتستانتية، التي يعمل فيها 627349 موظفا، و700 ألف متطوع. وجمعية كاريتاس التابعة للكنيسة الكاثوليكية، التي يعمل فيها 729410 موظفين، ومئات آلاف المتطوعين. وهذه أرقام مهولة لموظفين يتبعون للمؤسسة الكنسية فقط يفوق عددهم، على سبيل المثال، كلّ الموظفين في دولة سورية البالغ عددهم قرابة المليون وربع المليون موظف.
واليوم نسمع أصواتاً ألمانية تنتقد هذه (المعونات)، وهنالك محاولات عديدة من معظم الأحزاب الألمانية: اليسار، البديل، الخضر، لتغيير هذا الواقع على مستوى البوندستاغ، ولكنها تُقابل بالرفض، كرفض اقتراح الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ سنة 2017 لإعادة “تقييم المعونات الحكومية للكنائس”، أو كرفض دعوة حزب الخضر في التحالف الحاكم سنة 2020 أيضًا إلى إنهاء هذه “التعويضات” التي تقدمها الدولة، وما زال الألمان يسوّغونها برؤية حقوقية تاريخية عمرها قرابة مائتي سنة، وباعتبار الفوائد التي تحصّلها الدولة والمجتمع من وراء هاتين الجمعيتين الضخمتين اللتين توظفان قرابة المليون وثلاثمائة وخمسين ألف موظف، وهذا العدد الكبير يتلاءم مع ما تقدمه مؤسساتها من خدمات إنسانية لا تضاهى، في مئات المدن والبلدات الألمانية، كالمشافي، ودور كبار السن، ومراكز الرعاية النهارية، ومكاتب خدمات الفئات الضعيفة وتحديداً اللاجئين.
وبناءً على ما سبق نتساءل: هل نشهد في سورية حين كتابة دستورها القادم ما يسمى Staatsleistungen (معونات الدولة)، ضمن اتفاق يبرم بين الدولة ووزارة الأوقاف تعويضاً عن الاستيلاء على الملكيات والريع والمنافع من الأوقاف الإسلامية؟.
تمكن الإشارة هنا إلى مثالين من آلاف الأمثلة. الأول: استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي منذ أكثر من 40 سنة على الأرض الوقفية التي بنى فوقها ما يشبه القلعة لتكون مقرّاً لفرع حزب البعث في أهم موقع في مدينة حلب مطلٍّ على الحديقة العامة، من دون أن يدفع قرشاً واحداً مقابل هذا الانتفاع والإشغال. فأين التعويض؟ وأين الإنصاف؟
أما المثال الثاني فالخبر الذي قرأناه عن اجتماع موسّع عقدته وزارة السياحة في الـ21 من الشهر الماضي (إبريل/ نيسان) لمناقشة تأهيل مجمع التكية السليمانية وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية ودينية تستقطب الزوّار. كلّ ما ورد في هذا اللقاء والاجتماع لا يراعي لا من قريب ولا من بعيد المهمّة الأساسية لهذا المكان، وهو جامع للصلاة، ومدرسة للعلم والتعليم، وتكية لمبيت الطلبة الغرباء، وحوانيت لخدمة الحجاج الذين ينزلون بساحة المكان، ولا يراعي كذلك شرط الواقف بأن يكون المكان في عهدة مفتي دمشق، كما يذكر الغزي في كتابه الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، ولذلك فإن العدل والإنصاف ههنا يقتضي أحد حلّين: الأول أن يعود هذا المكان إلى ما أُسّس عليه، أو أن يُدفع التعويض المناسب تماماً مثلما فعلت ألمانيا.
وما نقوله هنا ينسحب أيضاً على جميع المدارس المسيحية التي استولت عليها الدولة بعد سنة 1967، وضمتها إلى وزارة التربية، وقد أعاد بشار الأسد استثنائياً سنة 2020 ثانوية الأرض المقدسة في حلب إلى الآباء الفرنسيسكان الذين يتراوح عددهم ما بين العشرة إلى الخمسة عشر راهباً.
أخيراً: خليقٌ بسورية والسوريين اليوم أن يستعيدوا مؤسّسة الوقف التي عطّلها الكائدون والواهمون والمغفّلون، فحرموا السوريين من خيراتها الوفيرة، وإمكاناتها التطورية المدرارة، وخدماتها الهائلة التي لا يمكن حصرها في مقال.
نقرأ، منذ فترة، دائماً عن رجوع رأسماليين صناعيين سوريين إلى مختلف المحافظات السورية. ما أحراهم وهم يبادرون إلى إعادة العمل والإعمار أن يفكروا في تفعيل هذه المؤسسة التي أُميتت على مدار قرن، وحُصرت في المسجد بينما كانت 14 قرناً تشمل مناحي الحياة كافة.
العربي الجديد
————————
سوريّون فاشيّون/ حسان القالش
13 مايو 2025
واضحة حالة الاستقطاب السلبية في المجتمع السوري على خلفية تأييد الإدارة الجديدة أو معارضتها، لكن من هُم أطراف هذا الاستقطاب؟ هناك طرفان أساسيان: واحدُ يمثّل التعدّدية السورية ويضمّ أفراداً من مختلف الانتماءات، هو طرف سلميّ يعارض النواحي السلبية في سياسة الإدارة. والآخر يضمّ المؤيدين للإدارة، من أشخاص يزعمون الحديث باسم “السنّة”، يدافعون عن الإدارة بشكل أعمى، انطلاقاً من عواطف انتقامية. والمعتدلون في هذا الطرف، وهُم قلّة، ينظرون إلى خطاب المعارضين على أنّه تضخيم للأحداث، وقد يكون ذلك صحيحاً، لكنه مقبولٌ طالما هي معارضة سلميّة منضبطة بمصلحة الوطن. لكن الحالة الحاضرة تجاوزت مجرد كونها استقطاباً حادّاً لتصل إلى مستوى العداء الصريح والمباشر، وجولة على العالم الافتراضي السوري كفيلة بتأكيد ذلك.
يتنامى هذا العداء في وقت تشهد سورية أحداثاً وظواهر ما كنّا لنتوقعها حتى من نظام وحشي كنظام آل الأسد: الاستهانة السافرة بشعب ذي خبرة تاريخية عريقة، تمثّلت في قوانين وإعلان دستوري وتعيينات تعود بالبلاد إلى الوراء، واستهداف للأقليات تتصاعد وتيرته. هذا بالإضافة إلى حريّة العمل والحركة لعناصر محسوبين رسمياً على الإدارة، المنخرطين في سياسة تأديب الناس وإعادة تربيتهم وتعليمهم الأخلاق والدين والتفريق بين الصالح والطالح، سياسة أسلمة للدولة والمجتمع ليكونا على نموذج بشع وظلامي يهيمن على مخيّلة هؤلاء.
المصيبة في هذا كلّه أنّ تأييد الإدارة وتبرير ارتكاباتها هذه من شريحة كبيرة من مؤيديها يؤشّر على مقتل الروح الإنسانية المشتركة ومعها قيم الحق والأخلاق والحرية والكرامة. هذا ما نجده في ردود الأفعال على التهجير الطوعي الذي حصل مع طلاب الجامعات الدروز مثلاً، فالمشهد الذي صاحب الحدث يمرّ سريعاً دون انفعال عاطفي، شيء من التطبيع السيكولوجي مع المأساة، كما يحدث مع المشاهد القادمة من غزّة المستباحة، على أنّ تأملاً لخمس دقائق في هذا الحدث كفيل بإصدار صرخة تمزج الغضب والألم واللّوعة، لا على شباب الدروز بوصفهم دروزاً، بل على سورية التي نعرفها، بحُلوها ومُرّها. لكن للأسف الحالة أخطر من ذلك بكثير، فمشهد التهجير الجماعي “الطوعي” للطلاب الدروز لم يكن مجرّد مشهد طبيعي لا يستحقّ التفاعل، بل كان مشهداً أخرج من صدور الكثيرين أقذر ما في ذواتهم من حقد وشماتة وانعدام الوطنيّة.
الأمر ذاته حصل أخيراً مع عودة أخبار اختطاف فتيات سوريات علويّات، فعدا عن الإنكار والتبرير والتشفّي، لم يستنكر أحد من هؤلاء رؤية إحدى الفتيات وهي ترتدي زيّاً لا ينتمي لا لتاريخنا ولا إلى ثقافتنا ولا حتى للإسلام الصحيح. من فعل ذلك، أي من أجبَر هذه الفتاة على هذا المظهر وأراد عرضه على الملأ في قريتها وبين جماعتها وأهلها، يعرف جيداً قيمة الصورة والرّمز على إرسال الرسالة، وهي رسالة بأنّ جماعة نافذة من المحسوبين على الإدارة يتمتعون بصلاحية مطلقة لفعل ما يريدون، وأنهم غير معنيين بكل ما يجري في البلاد من نقاشات سياسية أو خطط للمستقبل، فهذا جزء من تقيّة سياسية بالنسبة للفاعلين على الأرض من رجال هيئة تحرير الشام وحلفائها. وعلينا ألا نغشّ أنفسنا بالقول إنّ الشريحة الممسكة بالحكم في الهيئة منشغلة في البحث عن شرعيّتها في الخارج، فهي تعلم علم اليقين ما يحدث، خاصة وأنّ ذريعة فوضى الأيام الأولى من التحرير لم تعد ذات جدوى في هذا المجال.
العربي الجديد
—————————–
صباح الخير أيّها الخوف/ رباب هلال
13 مايو 2025
تجول عيناك وجوهاً وأجساداً يتآكلها الحذر والخوف مجدّداً. تسبر نظراتك العيون، تحدّق في الفضاء السوريّ الكالح، يشحنه التربّص، التشبيح، والتجييش، التحريض الطائفي، قتل على الهويّة الطائفيّة، قتل بذرائع واهية سخيفة يطلقها عملاء مأجورون، وطائفيّون موتورون من جميع الأطراف، ذباب إلكتروني محليّ وعربي ودولي، يمارسون لعبة الدم. اتهامات واتهامات مضادّة، سرديّات مظلوميّات حقيقيّة، وأخرى كاذبة. عيون الضحايا من المدنيّين الأبرياء؛ عجائز وشبّاناً؛ نساء وأطفالاً، تحتفظ بصور قاتليها، تحيطها شماتة الانتقام الجسيم، والإمعان بالشكّ الفارغ في تحقّق حدوثها، أو تاريخه، بغية تكذيبها ونكران مرتكبيها الحقيقيّين، ومطالبة الإعلام الرسميّ بإعلان الحقيقة، إعلام يذكّر بالإعلام الأسدي الهزيل وتضليله الفاقع. في الحين لا يزال القتل يسري في مجازر جماعيّة أو فرديّة، هنا وهناك. إضافة إلى نهب الممتلكات والبيوت أو إحراقها، والخطف، وبوجه خاصّ لنساء من طائفة بعينها.
يستغيث الحاضر، فيتصدّى له عتاة التشبيح والانتهازيّين والمستفيدين الجدد من يساريّين تائبين، ومثقّفين وفنّانين وكتّاب، بينهم من صمت سابقاً صمت الأموات، برفع القوائم الأسديّة المشينة بجرائمها وفسادها. إلى أن باتت تلك القوائم المرفوعة اليوم تبريراً سافراً لكوارثنا السوريّة القائمة.
ذلك كلّه، يدور وسط ضبابيّة سلطويّة وقانونيّة، وفلتان أمنيّ مرعب، تحت سماء يستبيحها العدوان الإسرائيلي، في كلّ أطرافها، وفي قلبها دمشق.
صباح الخير، أيّها الخوف. مساء الخير، أيّها الرعب.
على مدى عقد ونصف العقد، خسرنا كثيراً من الطاقات الإبداعيّة، قتلاً، واعتقالاً وتهجيراً، فأصيبت البلاد بالفالج. واليوم، تعاني المؤسّسات التعليميّة بمراحلها المختلفة من خطر كارثيّ يتجدّد ويتّسع على الجغرافيا السوريّة، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنيّة. فرغت المدارس، والمعاهد والجامعات، لمدّة طويلة من الطلّاب والكوادر التعليميّة، وإن اختلفت نسبيّاً بين منطقة وأخرى، تبعاً للترهيب والترعيب، وحدوث معارك ومجازر، قتل فرديّ وخطف، لأساتذة وطلّاب، وطالبات بشكل خاصّ، ليس آخرها خطف الطالبة ميرا جلال ثابت في حمص، التي اختفت في المعهد خلال تقديمها الامتحان، بحسب شهادة والدها الذي رافقها، ومكث عبثاً ينتظر في سيّارته الخاصّة أمام المعهد خروجها لإعادتها بأمان وسلام إلى المنزل. في وسط المعهد، اختفت ميرا الصبيّة الصغيرة، لتظهر بعد أيّام عديدة، بلباس عجيب غريب، كأنّما يخبّئ عورة، وملامح وجه مجبولة بالخوف والقهر والذلّ، رفقة رجل يعلن أنّها زوجته شرعاً. فأيّ شرع يقضي بانتهاك صارخ، وإجرام أخلاقيّ قانوني يطاول المرأة، وينال من كرامتها وعفّتها، ويغتصب جسدها، روحها، مستقبلها وحياتها؟ وأيّ شرع يستبيح عرض الآخر وشرفه ويقتل مستقبله، ويكمّ فمه عن قول الرواية الحقيقيّة تحت التهديد والوعيد، كما حدث لثلاث نساء أو أربع فقط، عُدن إلى عائلاتهنّ بعد خطفهنّ؟
حرمان الطلّاب عامّة من حقّهم الإنسانيّ والقانوني والشرعيّ في التعليم، سواء في حمص أو وحماه أو الساحل، واليوم، يطاول طلّابنا من محافظة السويداء الذين يهربون من جامعات حمص ودمشق وحلب.
متى سيبدأ مسار العدالة الانتقاليّة وتطبيق القانون بشكل حقيقيّ وفعّال وعادل؟ ومتى ستعود الحياة الطبيعيّة اليوميّة التي يكاد الترعيب والتهديد يشلّها حتى الساعة، في أغلب مناطق البلاد؟ فهل تتعافي البلاد كلّها، وعلى رأسها دمشق، وأطرافها مشلولة. فسوريّة لن تكون بخير إطلاقاً، قبل أن يهلّ الفعل المضارع على جهاتنا كلّها أبيض وورديّاً لونيْ أصالة قلوبنا السوريّة المنهكة الضالّة.
العربي الجديد
—————————-
هل يتحول برج ترامب في دمشق إلى واقع بعد رفع العقوبات عن سورية؟/ عدنان عبد الرزاق
13 مايو 2025
أكد الباحث السوري المقيم بالولايات المتحدة، رضوان زيادة، أن برج ترامب في دمشق “سيغدو واقعاً على الأرض بالفترة المقبلة، وذلك بعد مباحثات ومشاورات عدة، مع جهات أميركية والشركة التي ستنفذ المشروع”، مزوداً “العربي الجديد” بتصميم أولي للمشروع الذي سيكون الأعلى بالعاصمة السورية، مضيفاً أن “هناك احتمالات عدة للمنطقة التي سيكون فيها البرج لم تحدد بدقة بعد”.
وحول الشركة التي ستنفذ برج ترامب، والذي سيضم شققاً سكنية وغرفاً فندقية ومحال تجارية ومكاتب للشركات، أضاف زيادة أن شركة “تايغر” للتطوير العقاري المؤسسة منذ عام 1976 بالإمارات، والعائدة لرجل الأعمال السوري وليد الزعبي، هي التي ستنفذ المشروع. وتعمل مجموعة تايغر التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المولود في مدينة درعا جنوبي البلاد، في قطاعات عدة، وينصب تركيزها الرئيسي على أعمال العقارات. كما أسس الزعبي “جامعة اليرموك الخاصة” في سورية عام 2005، وفي عام 2012 أسس مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين “مجلس رجال الأعمال السوريين للإغاثة والتنمية” في الإمارات.
ومن دمشق، قال الباحث، محمد الخضر، إننا “سمعنا بالبرج عبر الإعلام ولكن على الأرض لا يوجد أي شيء بعد”، متوقعاً أن “يرى المشروع النور إن سارت الأمور بسياقها الطبيعي، لأن قرارات الرئيس الأميركي متقلبة ولا يمكن الركون إليها أو البت بمشروع أو علاقات، من دون أن نرى واقعاً على الأرض” بحسب تعبيره. وأضاف خضر لـ”العربي الجديد” أن “دمشق التي تعاني من واقع بائس بأمس الحاجة لعلامات كبرى وشركات دولية لتضخ بها الحياة، بعد سني الحرب التي أفقرت الشعب وكست الأبنية بمسحة سواد وحزن”.
وأشار إلى أن “دمشق، تكاد تكون من العواصم القليلة بالعالم التي لا تضم أبراجاً، كما دول الخليج وحتى بيروت، فمعظم المباني قليلة الطوابق، وكان العذر بالماضي بسبب تربتها الهشة ومرور نهر بردى”، مضيفاً أن “هذه أعذار وطرق تهرّب، لأن التقنيات اليوم سمحت ببناء برج خليفة الذي يعد أعلى برج بالعالم على أرض رملية”.
برج ترامب في أكثر من دولة
ويهتم الرئيس الأميركي ببناء أبراج باسمه حول العالم، بعد أول برج باسمه في عام 1983 في الجادة الخامسة في مانهاتن بارتفاع 58 طابقاً وجد بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكنه، إلى جانب العديد من المتاجر للأعمال التجارية. وكانت إسطنبول قد افتتحت في منطقة “ماجيديا كوي”، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برجي ترامب في إبريل/نيسان 2012 ليضم نحو 200 شقة سكنية و128 مخزناً ومتجراً لأشهر الماركات التركية والعالمية إضافة إلى مولات تجارية ونواد رياضية.
وسرت شائعات في تركيا لتغيير اسم برجي ترامب، بناء على طلب الرئيس التركي، بعد الانقلاب عام 2016 ومخالفات مالية على شركة “دوغان” التي بنت وتشرف على برجي ترامب بعد اتفاقها مع مجموعة ترامب الأميركية عام 2008 لبناء البرج ليفتتح عام 2012. ويتألف المشروع من برجين، الأول 29 طابقاً، مخصص للسكن يضم نحو 200 نوع “ريزدانس”، والثاني 37 طابقاً وهو مخصص للمكاتب والشركات والمحال التجارية، فضلاً عن قبو للنبيذ بطاقة تخزينية تصل نحو 16800 ليتر، وهو الوحيد بإسطنبول.
ويركز عمل مجموعة دوغان بتركيا، على مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك المجموعة أشهر الصحف التركية أبرزها “حرييت”، و”ميلليت”، و”راديكال”، و”بوستا”، و”يورت” بالإضافة إلى قنوات “سي أن أن تورك” الإخبارية و”كنال دي”، و”ستار” العامتين ووكالة أنباء دوغان، وهو ما كان يمثل 40% من إجمالي وسائل الإعلام في تركيا.
تاريخ العقوبات الأميركية على سورية
وتعول دمشق على زيارة الرئيس الأميركي لمنطقة الخليج العربي وزيارته السعودية وقطر والإمارات، سواء بلقاء متوقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أو رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وكان ترامب، قد ألمح أمس، إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لتمكينها من تحقيق “انطلاقة جديدة”، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين.
وتطالب حكومة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الذي هدمه النظام المخلوع، خلال سنوات الثورة، قبل أن يسرق ما تبقى ويهرب إلى العاصمة الروسية موسكو.
ولا ترتبط العقوبات الأميركية على سورية بعهد جرائم بشار الأسد بحق الثوار أو تهريب المخدرات، بل تعود إلى نحو 45 عاماً، مع إدراج الدولة العربية في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ديسمبر/ كانون الأول 1979، مما أدى إلى حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية وفرض قيود مالية وبعض الضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، كالمعادن والنفط والفوسفات.
وزادت العقوبات الأميركية وفق ما يسمى “قانون محاسبة سورية” في مايو/ أيار 2004 وقت فرضت واشنطن ضوابط إضافية على الاستيراد والتصدير، وفي عام 2006، جرى فرض قيود جديدة على صادرات المواد الحساسة، بما يتضمن التقنيات الطبية وعدد من المنتجات الاستهلاكية. كما استهدفت العقوبات البنك التجاري السوري “حكومي” ومنع المصارف الأميركية من التعامل معه، قبل أن تتوسع عام 2008 العقوبات على المصارف السورية بسبب اشتباهها بدعم نشاطات “تمويل الإرهاب”.
وبعد قمع نظام الأسد البائد للثوار عام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام وحظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سورية، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%. لتتبعها عام 2012 بعقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سورية وتتبعها عام 2017، بعقوبات على 270 موظفاً حكومياً بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وبعد تسريب صور التعذيب حتى الموت في سجون ومعتقلات نظام الأسد، فرضت الولايات المتحدة عام 2020 عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون “قيصر” لتشمل هذه المرة قطاعات حيوية كالطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه، عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
وتضمن القانون تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر دعم المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار، وتطول العقوبات أيضاً الشركات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السوري.
وبعد استفحال تصنيع وتهريب المخدرات من سورية وعبرها، أقرّ مجلس النواب الأميركي، في سبتمبر/أيلول 2020، قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، القانون “كبتاغون 1” والذي نص على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو “تهديد أمني عابر للحدود الوطنية” للحكومة الأميركية، لذا هدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.
والعام الماضي صدر قانون “كبتاغون 2″ الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد. ومنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. ووفق قانون “كبتاغون 2″، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
العربي الجديد
———————————-
أوي لي/ يعرب العيسى
13 مايو 2025
نجا السريان والآشوريون من طوفان نوح، وغزوتي المغول، وموجات الطاعون الكبرى في القرن السابع والحادي عشر والرابع عشر، وستة زلازل كبرى، وموجات جفاف امتدّ بعضها خمسين عاماً، وتغير الأديان واللغات، وثلاثة وسبعين خليفة عباسياً وعثمانياً نصفهم نصف مجانين، ومن تبدّل الإمبراطوريات عشرات المرّات في الأراضي التي يسكنونها.
ظلّوا سرياناً وآشوريين، صار أغلبهم مسيحيين، توزّعوا بين الكاثوليك والأرثوذكس. أسلم بعضهم، وذاب في المحيط الواسع ونسي مع الزمن أسماء أسلافه. ظلّوا فلاحين يزرعون القمح حيث زرعه أجدادهم قبل التاريخ. تعلّموا اللغات الجديدة، ولا سيما العربية، وبعض الكردية، لكنهم حافظوا على لغاتهم القديمة، على الأقل في الصلوات والمراسم الدينية وأسماء الأبناء.
لكنهم استسلموا أمام أعداء أقلّ بأساً بكثير، مثل عدم توفر فرص عمل، تردّي الاقتصاد، التضييق على الحريات، حكم البعث في سورية والعراق، العبث بمناهج التعليم، بضع هجمات دموية قام بها تنظيم داعش على قراهم الصغيرة في محافظة الحسكة.
في التحقيق المنشور في الصفحتين، الثانية والثالثة، من هذا العدد من “سورية الجديدة” عن هجرة مسيحيي الجزيرة السورية، يحكي الزميل ريمون القس الفصل الأخير من هذه الهجرة، التي تصاعدت في السنوات الأربع عشرة الماضية، بوتيرةٍ غير مسبوقة في التاريخ، إذ هاجر خلالها اثنان من كل ثلاثة سريان كانوا هنا، في أرض أجدادهم، أجدادهم حتى أول الزمان.
قبل سنوات، تعرّفت برجل اسمه آشور، هرب بعائلته إلى بيروت بعد مجزرةٍ داعشية قتلت أربعين من أقاربه، تجاورْنا في بناء واحد عامين تقريباً، ريثما حصلوا على تأشيرة الهجرة إلى أستراليا. يوم ودعتهم، عانقت ابنه تَغْلَت (طبعاً ابن آشور سيكون تغلت)، وكان في الخامسة عشرة يومها، وقلت له: ارجع، يا بني، ارجع عندما يحين الوقت، يوماً ما سيزول كل هذا السواد، وستعود البلاد إلى أهلها، هذه الأرض لك أكثر مما هي لي.
وعدني تغلت أن يعود فيما يخفي ارتباكه من بكاء أبيه أمامه، ولا أعرف إن كان سيفي بهذا الوعد، ولكني أعرف أن هذه البلاد تفقد ملحها، وتفقد جزءاً أصيلاً وحميماً من روحها بهجرة مسيحيي الجزيرة السورية، التي لم تكن سوى امتداد لهجرة مسيحيي العراق التي سبقتهم ببضع سنوات، ونتيجة طبيعية لكل ما جرى ويجري وسيجري على هذه الأرض التي لم تتوقف عن إنجاب أبناء منذورين للرحيل.
يركّز الاهتمام الإعلامي اليوم بمكوّنات المجتمع السوري على العلويين والدروز والمسلمين السُّنة، بسبب طزاجة مجازر الساحل، والهجمات على السويداء وجرمانا وصحنايا. وربط ذلك بتجييش طائفي يحاول أن يُجهز على ما تبقّى من الهيكل العظمي لهذه البلاد، عبر صفق عظامه ببعضها، وانتظار أن تهشّم نفسها بنفسها.
ولا تقلّ الأرقام التي يذكرها التحقيق عن هجرة المسيحيين فظاعة ورعباً عن أي مجزرة، وتستحقّ توقفاً ونقاشاً جدّياً وعميقاً في معنى هذه البلاد، وفي الحجم الضئيل من المعرفة الذي تمتلكه عن نفسها.
إحدى السرديات الشائعة حالياً تستحضر الدولة الأموية شعاراً، من دون أن تجهد نفسها في معرفة الدولة الأموية الحقيقية، وطريقتها في إدارة هذه البلاد المعقّدة والمتنوّعة، التي يمكن اختصارها بأن مسيحياً واحداً لم يهاجر خلالها.
ثقافياً وإنسانياً ووطنياً: ܐܘܝ ܠܝ (أوي لي)، وهي كلمة سريانية آرامية تعني بالعربية: يا للأسف، يا ويلي.
العربي الجديد
—————————–
اليمامة التي تدمشقت/ آلاء عامر
13 مايو 2025
زرتُ، في بداية الثورة، مرسم الفنان التشكيلي يوسف عبدلكي في دمشق، وعندها انهارت إحدى مسلماتي التي تربّيت عليها، وكان من المستحيل بالنسبة لي التشكيك فيها.
من تلك المسلمات التي توارثناها أباً عن جد، وكانت تقول بحزمٍ لا يقبل الجدل أو النقاش: “تربية الحمام سوسة الزعران”.
عبارة تردّدت في بيتنا تحذيراً مقدّساً، كناية عن انحراف مربي الحمام المحتوم. كانت أشبه بإشارة خطر حمراء: من يربِّ الحمام يُصنَّف تلقائياً في خانة “المشبوهين”، أو على الأقل “غير الجديرين بالثقة”. ومن المدهش أن هذا الحكم لم يكن بحاجة لأدلة، لم يكن يُبنى على سلوك أو مواقف، فمجرد ذكر أن فلاناً “يربّي الحمام” كان كافياً لتغيب صورته في ضباب الشك. لكني في ذلك المرسم الغائر في حارات الشام القديمة، وفي تلك اللحظة العابرة، شاهدتُ ما لم يكن ممكناً حسب منطق تلك المسلّمة:
يوسف عبدلكي، الفنان المثقف، المُحترم، الهادئ، الذي ترسم أنامله موتى الوطن بشفافية موجعة، يربّي الحمام. بل إن اليمامة “الستيتية” نفسها، ذلك الطائر الذي كنا نربطه بعوالم الزعران والسرسرية، كانت تتمختر أمامي، حرّة طليقة في باحة المرسم، وكأنها جزء عضوي من تكوينه الفني، من روحه الهادئة، من الحنين الذي ينسكب في لوحاته من دون كلام.
كانت الصدمة شديدة لدرجة أنني لم أصدق نفسي. حين عدتُ إلى البيت، رويتُ الحكاية لأبي، انفلتت من فمه العبارة بسرعة خاطفة، وكأنه واجه نوعاً من الكفر السلوكي: “بيربّي حمام؟! يا لطيف… الله يجيرنا من هالسوسة”. ضحكت في داخلي، لا سخرية من والدي، بل من هشاشة الصور التي تُبنى عبر الأجيال، كيف يمكن لعادة بسيطة، مثل تربية الحمام، أن تتحوّل في وعينا الجمعي إلى تهمة اجتماعية؟
في أماكن كثيرة من العالم، تُعتبر تربية الحمام هواية إنسانية وراقية، ترتبط بالصبر والملاحظة والتفاعل الحميمي مع كائن هشٍ يحتاج التعامل معه إلى اللطف والحذر، في كتب الأطفال، الحمام رمز للسلام، في السينما يرمز للحب والحنين والعودة.
ولكن في سورية، أو على الأقل في الشريحة الاجتماعية التي أنتمي إليها، ارتبط الحمام بعالمٍ مريب: عالم السطوح والغموض والسرّية.
المربي هو “العوايني” الذي يُقال إنه يراقب الجيران ويكتب التقارير، أو هو “الهارب” الذي يقفز من سطحٍ إلى سطح، أو ربما هو المراهق عديم المسؤولية. نذر حياته لمطاردة الطيور، وتحريرها، وترويضها، وكأنه يهرُب من الحياة نفسها.
عبدلكي، بهدوئه الذي يشبه هديل الحمام، بنظراته العميقة التي تستخرج الضوء من الظلام، بفنّه الذي لا يصرخ لكنه يوجع، فكّك هذا الارتباط في لحظة واحدة، أثبت أن مربي الحمام ليسوا زعراناً، بل أحياناً يكونون فنانين، أو عشّاقاً، أو أطفالاً كبُروا من دون أن يتخلّوا عن أجنحتهم.
لم يكن الحمام في مرسم عبدلكي مجرد طيور ترفرف، بل كان استعارة حيّة عن الحرية، عن الترويض الحميمي، عن الصداقة الهادئة مع شيء لا يُروّض ولا يُربى إلا بالحب.
شهادة غير مقبولة
حين سألتُ مؤرّخ التراث الشفهي الراحل سمير الطحان عن سبب قول الناس إن “شهادة الحميماتي غير مقبولة”. روى لي قصتين: تقول الأولى إن “حميماتياً” طُلب منه الشهادة في قضيةٍ ضد قريبٍ له، فإن شهد بالحق سُجن قريبه، وإن كذب خان ضميره، فقرّر أن يهرُب من الموقف، بأن أحضر معه طائر حمام وخبأه في صدره، وعندما وقف أمام القاضي للقَسم، أطلق الطائر في قاعة المحكمة، فعمّت الفوضى، وبدأ الحضور يركضون لالتقاط الطائر، ما أغضب القاضي الذي طرده، وأعلن عدم قبول شهادة الحميماتي.
التفسير الثاني الذي ذكره الطحّان، وربما يكون الأقرب إلى الواقع، أن هؤلاء يحبّون الحمام إلى درجة الجنون، فبمجرّد أن يقع بين أيديهم طائر حمام مميز، فإنهم قد يقسمون ويُلحّون في القسم أنه ملكهم، ليس لأنهم يتعمّدون الكذب، بل لأن حبّهم المفرط يجعلهم يصدّقون ما يتمنّون. ولذلك يُقال إن قَسَم الحميماتي لا يمكن الوثوق به، وبالتالي، لا تُقبل شهادته.
الستيتية طائر الست عشتار
تقول الأسطورة إن “الستيتية” ذلك الطائر الذي يحرّم الدمشقيون صيده أو إيذاءه أو حتى تحريك عشّه، لم تكن مجرد طائر حمام بنيّ يختال على الأسطح ويقضم حبات القمح بطمأنينة، الستيتية كان، في أصل الحكاية، من نسل الطائر الأسطوري الأعظم: العنقاء. ذاك الكائن الناريّ، الجامح، الذي يعبر السماوات والصحارى والبحار من دون أن تلجمه جهة أو تسجنه حدود. طائرٌ يتغذّى على النار، ويولد من رماده، لا يعرف الهدوء، ولا يساكن الأرض.
لكن وبينما كان العنقاء يحلّق لمح دمشق، فأسره سحر المدينة وجمالها، حتى توقف قلبه عند معبد عشتار؛ “الستّ” ربة الجمال والحياة، فانجذب إلى معبدها، وشرب من نبعها المقدّس، فبدأ ريشه القوي بالتساقط، وسكنت روحه الجامحة، وتحول من طائرٍ أسطوريٍّ جبار، إلى كائن مسالم يعيش بين الناس، ويشاركهم شوارعهم وأحاديثهم وأسقف بيوتهم، تخلى الطائر عن طبيعته المتوحشة وصار طائراً متمدناً تعلم العيش في المدينة، بعد أن خالط أهلها الذين توالت على مدينتهم الحضارات، حتى صار التمدن والتحضر جزءاً من جيناتهم.
ومنذ ذلك اليوم، أطلق الدمشقيون عليه اسم “الستيتية”، تصغيراً لكلمة “ستّ”، تيمّناً بالست عشتار، فدمشق، وكما هو الحال في قلة من العواصم العريقة، لا تترك من يمرّ بها كما كان، بل تُهذّبه، وتمنحه اسماً جديداً، وقلباً جديداً، وروحاً تليق بها، كأنها تمنحه فرصةً أخرى للحياة على طريقتها الخاصة، وتعيد تشكيله بما يتناسب مع عظمة هذا المكان الذي لا يُشبه سواه.
بعد أن تدمشقت “الستيتية”، أصبح صوتها الخافت الحنون جزءاً من هوية الشام وصباحاتها، وهو صوتٌ محبّبٌ لدى الدمشقيين، الذين يقولون إنها توحّد ربها كلما صدح صوتها.
أما عن خوفنا، نحن السوريين، من مهنة تربية الحمام، فهو ليس خوفاً بريئاً ولا عفوياً، بل هو خوفٌ دُسَّ فينا بدهاء، حتى صار جزءاً من نسيج وعينا الجمعي؛ خوفٌ اخترعه نظام قمعي طالما أخافته الأجنحة والحرية، فالأسطح كما أرض ديار كما السماء السطح، حيث ترفرف الطيور، مساحة لا يمكن ضبطها أمنياً، لا توجد له أبواب ولا حواجز تفتيش في المساحات التي تفلت من الخرائط الرسمية، ومن جغرافيا القمع.
العربي الجديد
————————-
القامشلي… مدينة القصب والتنوّع والتعايش/ محمد أمين
13 مايو 2025
على أطراف الخريطة السورية الشمالية الشرقية مدينة تُدهشك بكل شيء. تدهشك بتنوع سكّانها. لم تستهوهم بضاعة مثقفين طارئين تفرّق ولا تجمع، وتشتت ولا توحّد في زمن تسوده الفوضى في كل شيء.
لا تزال هذه المدينة صغيرة تحبو إذا ما قورنت مع المدن السورية العريقة، فعمرها نحو مائة عام فقط. إنها مدينة القامشلي التي تختصر سورية من حيث التنوّع السكاني والتعايش الأخّاذ الذي يسودها، والذي لم تشبه شائبة، رغم كل ما جرى في سورية على مدى عقد من الزمان. تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة، إلا أن القامشلي حاضرة في المشهد السوري منذ تأسيسها على يد الفرنسيين في منتصف عقد العشرينيات من القرن الفائت، حين وُضعت الحدود ما بين سورية وتركيا. اسمها مشتق من معنى القصب باللغة التركية (kamış) الذي ينتشر على ضفتي نهر جغجغ الذي يخترقها من الوسط قبل أن يلتحم مع الخابور ليشكلا نهراً واحداً يتجه جنوباً ليرفد نهر الفرات. القامشلي اليوم متعبة مثل باقي المدن السورية بسبب سنوات الجمر التي مرّت على البلاد. تُعَدّ اليوم العنوان البارز للتعايش المثالي والحقيقي بين كل السوريين، بكل مكوّناتهم العِرقية والدينية والمذهبية. في القامشلي، مسلمون ومسيحيون، كرد وعرب، وأرمن. وكانت في يوم ليس بعيداً تضم يهوداً كان لهم دور بارز ومؤثر، لا تزال آثاره موجودة في نهضة القامشلي. قدم اليهود إلى القامشلي من مدينة نصيبين مع السنوات الأولى لتشكيلها، وباتوا جزءاً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمدينة. ولا يزال أشهر الأسواق في المدينة يحمل اسم “عزرا”، اليهودي الذي أسس هذا السوق في بدايات تشكيل المدينة، لذا يعتبر من معالمها التاريخية.
في المدينة عدة أحياء، لعل في مقدمتها حي “الوسطى”، وغالبية قاطنيه من المسيحيين السريان والأرمن، وكان يقطن فيه اليهود قبل هجرة آخر عائلاتهم من سورية في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم. وهناك حي “طي” المستمدّ من اسم القبيلة العربية المعروفة، ومعظم سكانه من العرب الذين يتشاركون مع الكرد في حي “زنود”. ويشكل الكرد غالبية قاطني أحياء الهلالية والكورنيش وقدور بيك والزيتونية إلى جانب بعض السريان والغجر. القامشلي التي كان عدد سكانها قبل عام 2011 نحو مائة ألف كبرت في أثناء الحرب بسبب قدوم نازحين إليها من مختلف المناطق السورية بحثاً عن ملاذ آمن، وباتوا بعد أكثر من عشر سنوات جزءاً من أهلها. يفصل بين القامشلي وأختها مدينة نصيبين التركية خط الحدود ما بين البلدين. ولكن البون شاسع بين المدينة من حيث التطور العمراني، فالنظام المخلوع لم يُولِ القامشلي الاهتمام الذي تستحقّه، ولا تفعل اليوم سلطة الأمر الواقع الموجودة.
إنّ من يزور القامشلي ولا يجلس في أشهر مقاهيها، “كربيس”، فكأنه لم يزرها. ففيه جلس ذات يوم الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين في أثناء هروبه الشهير من العراق إلى سورية عندما كان فتى في بداية الستينيات من القرن الفائت. وفي “كربيس” جلس الزعيم جمال عبد الناصر عندما زار القامشلي إبّان الوحدة السورية المصرية (1958-1961)، حيث ألقى خطاباً في فبراير/ شباط من عام 1959 لا يزال حاضراً في ذاكرة المدينة. القامشلي مدينة السياسة، ففيها رأى النور عديد من الأحزاب الكردية التي تعرّض المنتسبون إليها للاضطهاد زمناً طويلاً، مثل كل السوريين إبّان عهد الأسدين البائد. لا تزال القامشلي ومعظم محافظة الحسكة خارج نطاق الدولة السورية بعد تحرير البلاد من نظام الأسد في 8 ديسمبر (2024). تفرض السيطرة عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من خلال “الإدارة الذاتية” ذات الطبيعة الكردية. لم تصل تبعات الحرب السورية السيئة والسوداء إلى مدينة القامشلي، حيث لم تطاولها براميل الأسد وصواريخه بعيدة المدى التي دمّرت مدناً وأزالت أحياءً كاملة في مدن سورية، إلا أن المدينة تعرّضت لتهديد من تنظيم داعش الذي هاجم محافظة الحسكة ووصل الى منطقة تل تمر التي تحولت إلى ساحة حرب طاحنة انتهت باندحار هذا التنظيم بعد خطفه مئات الأشوريين. القامشلي التي تتبع لها إدارياً عشرات البلدات والقرى العربية والكردية والمختلطة، تقع على أطراف خريطة السوريين الجغرافية، إلا أنها في قلبهم، ينتظرون نتائج التفاوض التي تجريها قوات “قسد” مع الإدارة السورية الجديدة لحسم مصير مدينة مدهشة بكل شيء قبلتها دمشق.
————————-
قنبلة داخل بيتنا/ شعبان عبود
13 مايو 2025
هاجم متشدّدون قبل أيام ملهى ليلياً في دمشق، وضربوا الموجودين فيه بأعقاب البنادق، ما أثار رعباً كبيراً عند الحاضرين. ورغم أن السلطات الأمنية المختصة أعلنت اعتقال المهاجمين، تكرّرت الحادثة بطريقة أشدّ في ملهى آخر يبعد عن الأول أقل من مائة متر، حيث جرى إطلاق النار، وقتل إحدى الفتيات وإصابة آخرين. وكلاهما في مركز المدينة. وأعادت تلك الحادثة إلى الأذهان حوادث أخرى مشابهة جرت خلال الأشهر الخمسة المنصرمة، تتعلق بتجاوز القوانين والتعدّيات على الحريات الشخصية لفئات اجتماعية متنوعة ومختلفة.
بصراحة، يواجه الرئيس أحمد الشرع، الذي جاء بخطاب براغماتي يركّز على المصالحة الوطنية، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة على أسس وطنية، تحدّيات متزايدة، ليس فقط من خصومه التقليديين، بل أيضاً من قاعدته الشعبية التي باتت في بعض أجزائها تتصرّف بطريقة تُقوّض هذا النهج التصالحي. صحيحٌ أن هناك غالبية من هذه القاعدة الشعبية لا تزال تعيش آثار أكثر من 13 عاماً من القمع والقتل والتعذيب التي مارسها النظام السابق، إلا أن وضعها يشبه اليوم وضع ذئب جريح، وخطاب المظلومية الذي تتبنّاه وتستخدمه ضد “الآخر” سيعقّد إمكانية التأسيس لعقد اجتماعي وسياسي وطني جامع ويصعّبها.
كانت البراغماتية التي تبنّاها الرئيس الشرع تهدف إلى تجاوز الاصطفافات الطائفية، وإعادة هيكلة الدولة على أساس المساواة والمواطنة، وتقديم رؤية وطنية تتجاوز منطق الغلبة والانتصار، إلّا أن بعض مكونات قاعدته الشعبية، والتي ساهمت على نحو رئيس في وصوله إلى السلطة، تتصرّف الآن بمنطق المنتصر المتغلّب، وتسعى إلى فرض هيمنة رمزية واجتماعية على بقية فئات المجتمع. ويحمل هذا السلوك، في طياته، خطراً مزدوجاً: فهو من جهة يعمّق مناخات الانقسام ويهدّد التعايش الهشّ بين المكونات السورية.
أعمال الاستفزاز وتلك المتعلقة بتجاوز القوانين وانتهاك الحريات الشخصية، مثل ذلك الهجوم على الملهى الليلي، وإنْ كانت تصدُر من فئة صغيرة، إلا أنها تأخذ صدى واسعاً، في مجتمع ما زال يعيش على وقع جروح الحرب والانقسام. هذه الممارسات تستخدمها بسهولة القوى المعادية لإعادة إنتاج خطاب الخوف والتخوين، كما تدفع كثيراً من الفئات الاجتماعية والمكونات الأخرى نحو الانغلاق والدفاع الذاتي، ما يعيد البلاد إلى دوّامة التوتر والتفكك.
في هذه اللحظة الحرجة، على الإدارة الجديدة مسؤولية مباشرة في ضبط سلوك قاعدتها المتشدّدة، لأن الشرعية لا تُبنى فقط على الدعم الشعبي، بل تكمن في القدرة على احتواء التطرّف داخل معسكر المؤيدين، ومنع تحوّله إلى قوة معطّلة لمشروع الدولة، فالتطرّف حين ينمو داخل جمهورك، يصبح خصماً لك في الوقت نفسه، ويؤلّب العالم ضدك، لأن العالم الغربي يمسك بمفاتيح الاقتصاد والإعمار من خلال سلاح العقوبات، وبالتالي لا يمكنك تجاهله.
وفي المقابل، تتحمّل المكونات الأخرى من الطيف السوري، بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية والسياسية والثقافية، مسؤولية موازية في التفاعل الإيجابي مع المرحلة، وعدم الوقوع في فخ الشك والتعميم. لا يمكن بناء دولة وطنية على قاعدة الريبة والانتظار السلبي لفشل المشروع، بل من خلال الانخراط النقدي والفاعل في مؤسّساته.
بناء دولة وطنية سورية لا يكون إلا بتجاوز مناخات الغلبة والتشدّد من جميع الأطراف، وتبنّي مشروع وطني جامع يقوم على العدالة والمساءلة والتنمية المتوازنة، فالمعركة اليوم لم تعد عسكرية، بل أخلاقية وثقافية، تتطلّب شجاعة في المواجهة مع الذات قبل الخصوم، ومسؤولية جماعية من كل السوريين للعبور إلى مستقبل مختلف… وقبل كل شيء، علينا الانتباه جيداً إلى ذلك الذئب الجريح داخل بيتنا.
العربي الجديد
———————————
سيف الرحبي… نانسي بيلوسي والجامع الأموي
الإثنين 2025/05/12
لَفَتَ انتباهي في سياق إحدى قنوات وسائل التواصل الشعبية، ذلك الفيلم من الثرثرة والرعب، لقاء أجراه الإعلامي اللبناني طوني خليفة مع المفكر الإسلامي السوري المستنير محمد حبش، وكل مفكر حقيقي في رأيي مستنير، سواء كان من هذا الدين أو ذاك، من هذا المذهب الفلسفي الفكري أو خلافه، أو كان لا منتمياً، مستنيراً بنور ربه ونور الحقيقة عبر اللهاث الشاق وراء أطيافها وشظاياها المتطايرة في الأزقة والمحيطات.
محمد حبش كان عضواً في مجلس الشعب إبَّان الحكم البائد وهو مجلسٌ أقرب الى الفكاهة السوداء منه الى مؤسسة تشريعية حقيقية، وله نَسَبٌ كبير بمجالس عربية كثيرة. ما لفت انتباهي حديثه عن المسجد الأموي وقت زيارة النائبة الأميركية نانسي بيلوسي فترة حكم اليميني المتطرف جورج بوش، سَلَف الرئيس الحالي ترامب في الانتماء الى اليمين المحافظ المتطرف، وإن تفوق عليه في فنون الصفقة والمقاولات. وكانت المرأة الثمانينية من أشرس معارضي الاثنين، تلك المرأة التي بلغت عقدها الثمانيني لكنها ما زالت تحتفظ بخفة الفراشة وبألق ذلك الجمال الآخذ في الذبول والأفول.
محمد حبش، الذي انضم إلى معارضة النظام الساقط لاحقاً، مثل الملايين من أبناء شعبه، سأل بيلوسي عما جذبها أكثر في سوريا التي تزورها خارج الإرادة الرسمية المجسدة في بوش الابن مدمرِ بلادِ الرافدين، أول حضارة على وجه الأرض وبلاد المشرق… فأجابت أن المسجد الأموي هو ما أثار انتباهها أكثر، فلم تكن تتصور أن مسجداً يحتوي على قبر مسيحي وعلى قبر يوحنا المعمدان أو النبي يحيى، وأضاف حبش أن في منطقة إدلب من سوريا هناك قبر الخليفة عمر بن عبدالعزيز وزوجته فاطمة التي أوصت بدفنها الى جواره في ذلك الدير المسيحي بإدلب.
المسجد الأموي الذي أخذ أبعاد هيئته المعمارية المكتملة وقت حكم الوليد بن عبدالملك بعدما أحكمت الامبراطورية الأموية قبضتها على العالم من حدود الصين الى جبال البرانس في أوروبا.
ما أود قوله اختصاراً بأن الحقبة الأموية ظُلِمَت في مسار التاريخ كتابةً وروايةً وبُثّت في تضاعيفها السموم وَلَيِّ الحقائق والانجازات العظيمة لتلك المرحلة على مَرِّ الدهور. منها ذلك الاعتراف بالتعددية الدينية والإثْنية على حد السواء، هناك علمانية على نحوٍ ما لم تُقص ولم تسحق مُكَوّناً أو بُعداً من أبعاد الشعوب على كافة الأراضي الممتدة في آفاقها الشاسعة أيما شساعة وترامي أممٍ وأطراف، كما تفعل الامبراطوريات والأنظمة السياسية القديمة في الغَلبة الجارفة الساحقة لكل تَمايُزٍ وتعدد الذي هو من طبيعة التكوين البشري على أي وجه من وجوه هذه الأرض.
والوقائع الدالة على هذه المقولة الجوهرية المهمة في مسار هذا التاريخ الملحمي الكبير، كثيرة وساطعة في الممارسات والنصوص والمأثورات، ساطعة للبحث الموضوعي للمؤرخ الذي يحاول مقاربة الحقائق وليس ذلك التشويه المقصود سلفا لنوازعَ وأهدافٍ شعوبيةٍ وعصبويةٍ منها تلك القديمة المعروفة أو التي تلبس لَبوس الحداثة لتسوّغ شَعوبيتها وحقدها بلغوانيةٍ منهجيةٍ زائفة.
(لولا دمشق لما كانت طليطلةٌ
ولا زهت ببني العباس بغدادُ)
لولا دمشق وبغداد والأندلس لما استوى عالم الراهن المتعدد بمثل هذه الحضارة التي بلغت من العلو والنضج شَأوًا يؤهلها للانهيار كما لاحت علاماته لفلاسفة غربيين وأدباء منذ القرن الثامن عشر، لكنها تواصل مسيرتها الكاسحة عبر تفرعاتها الكونية في مدن وقارات مختلفة.
ليست هذه الأسطر إلا إشارة للبحث والحفر في الحقبة الأموية التي شكلت الهوية العربية المنفتحة على كل مدارات الأفكار والأديان، المذاهب والعلوم.
ومَن يعرف بلاد الشام، يرَ هذا الأثر في عموم الشعب السوري قبل أن تحكمه الديكتاتوريات والعصبويات الطائفية، الآفلة بإذن الله.
(*) مدونة نشرها الشاعر العُماني، سيف الرحبي في منصة “إكس”
—————————–
حرائق الطائفية في سوريا تشتعل من جديد وسط صمت العدالة/ دانيالا ويلسن
12.05.2025
القلق منتشر بشكل خاصّ بين الطلاب الدروز في دمشق، وفي حمص، وحتى في اللاذقية، بعد أن سُجّلت هتافات طائفية وتهديدات ضدّهم داخل الجامعات ومساكن الطلّاب، تقول الطبيبة الشابة:”شاركت في مظاهرة في ساحة الأمويين عندما سقط النظام، يبدو ذلك وكأنه زمن بعيد”.
في بلدة الصورة الكبيرة الدرزية الصغيرة الواقعة على مدخل محافظة السويداء من جهة دمشق، يلوح مقام الخضر الديني متفحّماً. الهواء مُشبع برائحة الحجارة المحترقة والقماش المشتعل. نجمة خماسية؛ رمز الديانة الدرزية، اقتُلعت من سقف المقام.
“دخلوا وهم يصرخون الله أكبر، ثم استخدموا شموع المقام ليُشعلوا فيه النار”، يقول ليث؛ عامل بلدية محلّي يرتدي الآن ملابس قتالية: “ثم أهانونا بهتافات طائفية”، يرفض ليث قول المزيد خجلاً.
يقول رجل يقف بجانب ليث: “أنتم خنازير، خونة، أخواتكم عاهرات. هذا ما كانوا يصرخون به”.
بدأ الهجوم عند الفجر في 30 نيسان/ أبريل، وأمطرت قذائف الهاون على القرية لساعات. قرابة الساعة 6:30 صباحاً، وبعد توقّف وجيز سُمح للعائلات بالفرار، دخل مسلحون القرية، نهبوا البيوت، وأحرقوا المحالّ التجارية، وعبثوا بالمقام. لم ينجُ محلّ واحد، بحسب السكّان.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، بل كانت جزءاً من موجة أوسع من العنف الطائفي، الذي استهدف المجتمعات الدرزية في سوريا، اشتعلت بعد تداول مقطع صوتي منسوب إلى شيخ درزي يُقال إنه أساء للنبي محمد.
سارع زعماء في الطائفة إلى نفي الاتّهام، كما أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً يوم الثلاثاء في 29 نيسان/ أبريل، أعلنت فيه فتح تحقيق، لكنّ الضرر كان قد وقع.
بعد واحدة من أشد أحداث العنف الطائفي في تاريخ سوريا الحديث، وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قُتل ما لا يقل عن 134شخصاً بعد أسبوع من الاشتباكات في المناطق ذات الأكثرية الدرزية “السويداء، جرمانا، صحنايا، أشرفية صحنايا”.
شمل القتلى 88مقاتلاً درزياً، 14 مدنياً، 32 جندياً من وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية، وقوات عسكرية تابعة لهم.
شهود عيان يقولون إن عناصر من إدارة الأمن العامّ، أي شرطة الدولة الداخلية، كانوا حاضرين ومتواطئين، وتؤكّد بعض اللقطات التي انتشرت عبر الأنترنت وجودهم، لكنّ دورهم الكامل لا يزال غير واضح.
في الصورة الكبيرة، قُتل مدنيان، أحدهما كان عمّ ليث الذي: “كان جالساً فقط، أعزل. أطلقوا النار عليه، لم نتمكّن من سحب جثّته حتى اليوم التالي”، رصاصات فارغة على الأرض، وعلى جدار قريب، لطخات الدماء وثقوب أحدثها الرصاص تشهد على ما حدث.
يقول ليث بصوت متهدج: “اقتحموا أيضاً منزل والدي وعمره 82 سنة وضربوه، مزّقوا صورة عمّتي، رفعوها من على الحائط وداسوها، وهي كانت توفّيت قبل شهر”.
امتدّ العنف أيضاً إلى ضواحي العاصمة. في 29 نيسان/ أبريل، اندلعت اشتباكات في جرمانا، المدينة ذات الغالبية الدرزية جنوب دمشق. بعد أسبوع، امتلأت محطّة الحافلات في المدينة بمئات العائلات التي تحاول المغادرة، الطريق إلى السويداء مغلق، ولم يتبقَّ سوى بضع حافلات لنقل الناس.
ساندرا، طبيبة تبلغ من العمر 29 عاماً، تحاول الحصول على مقعد في إحدى الحافلات حيث الجو خانق، والركّاب يحشرون أنفسهم ثلاثة أشخاص في مقاعد مخصّصة لشخصين تقول: “كلّ الدروز يريدون العودة إلى السويداء. من بقي، بقي فقط بسبب عمله”.
العنف، الذي وثّقته مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار قلقاً وجودياً في أوساط الطائفة، التي تخشى أن تلقى المصير نفسه الذي لاقاه علويون في مجازر الساحل، التي وقعت قبل أسابيع.
كلّ شخص من الذين التقيناهم يعرف أحداً مات، أو جُرح، أو فُقد، أو شارك في القتال.
القلق منتشر بشكل خاصّ بين الطلاب الدروز في دمشق، وفي حمص، وحتى في اللاذقية، بعد أن سُجّلت هتافات طائفية وتهديدات ضدّهم داخل الجامعات ومساكن الطلّاب، تقول الطبيبة الشابة:”شاركت في مظاهرة في ساحة الأمويين عندما سقط النظام، يبدو ذلك وكأنه زمن بعيد”.
تعمل ساندرا في مستشفى “المجتهد” في دمشق، ولا تعرف إن كانت ستحظى في السويداء بأمان أكثر من دمشق، لكنّها تبرر سفرها”على الأقلّ سأكون مع عائلتي”. “رأيت ذلك بعيني قبل أربعة أيّام”، تواصل بصوت منخفض: “وصل تسعة جرحى من صحنايا إلى قسم الطوارئ، حاولت إحضار طعام لهم، أوقفني الأمن العامّ، وسألوني عن اسمي، قال لي صديق إنهم سخروا من الرجال لأنهم دروز، كما طُلب من الأطباء عدم إجراء تدليك قلبي لرجل مصاب، وتوفّي لاحقاً”.
عند أحد الحواجز تتوقّف الحافلة، تنظر ساندرا بقلق إلى رجال الأمن العامّ الواقفين في الخارج: “لا أثق بهم. لكن ليسوا جميعاً متشابهين، بعضهم طلب من الآخرين أن يتراجعوا عندما سألوا عن اسمي. وليس كلّ السنة متشدّدين، بل العكس، لدي أصدقاء منهم ساعدوني على الحصول على إجازة من المستشفى”.
امرأة أخرى، تقف قريبة تستمع: “أنتِ تعملين في مستشفى المجتهد؟ جدّي أُصيب في صحنايا الخميس الماضي، سمعنا أنه نُقل إلى هناك، لكن عندما جئنا لرؤيته، طردنا الأمن العامّ، ثم قيل لنا إنه نُقل إلى داريا للاستجواب. لا أخبار عنه منذ ذلك الحين، مرّ أربعة أيّام، عمره 75 سنة”.
هذه الموجة من العنف الطائفي ليست مجرّد ردّة فعل، إنها تعكس أحقاداً قديمة، نزاعات على الأراضي، ودوائر انتقام، وتفتّت عميق في سوريا ما بعد الحرب.
سامي وردة، ناشط يبلغ من العمر 27 عاماً من جرمانا، يحاول توثيق العنف مع مجموعة من أصدقائه: “خلال الحرب الأهلية، انضمّ 300 رجل من بلدتنا إلى ميليشيات الشبّيحة، قاتلوا في المليحة في عام 2014″، المهاجمون مؤخّراً جاءوا من هناك: “بعض مقاتلي حزب الله كانوا متمركزين أيضاً في جرمانا، وشاركوا في تلك المجازر آنذاك”.
بعض التحالفات التي تشكّلت خلال الحرب الأهلية والنزاعات المحلّية تشكّل فوضى اليوم.
رعب صامت في الساحل
في حمص وعلى طول المحافظات الساحلية، موطن الأقلّية العلوية في سوريا، الإحساس بالتهديد واضح، وإن كان أقلّ ظهوراً حالياً. في 6 آذار/ مارس، هاجم موالون سابقون للنظام القوّات الحكومية، مما أشعل مجازر أسفرت عن مقتل 1,334 شخصاً، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، منذ ذلك الحين، استمرّ العنف في الظلّ، أحد الاتّجاهات المقلقة: خطف نساء علويات
سجّلت “مجموعة السلم الأهلي “، وهي منظّمة غير حكومية تأسّست بعد سقوط الأسد، 72 حالة خطف نساء، منذ كانون الثاني/ يناير في شرق سوريا وحده.
علي حسن لم يسمع عن شقيقته منذ 13 نيسان/ أبريل شيئاً: “كانت بتول في حافلة متّجهة إلى صافيتا، كانت تراسل زوجها لتطمئن على ابنهما، ثم ساد صمت بعد الساعة الرابعة عصراً”.
آخر صورة لها تُظهرها مبتسمة، بالكحل حول عينيها، مصيرها مجهول يضيف حسن: “ذهبنا إلى الشرطة، واتّصلنا بمعارفنا في الأمن العامّ لا شيء”.
لا يتّهم حسن السلطات بشكل مباشر، لكنّ تقاعسهم يقول الكثير، يقول : “ليسوا مسيطرين، لا يملكون العدد أو القدرة، لو طُبّقت العدالة منذ البداية، لما حدث هذا كلّه”.
تعلو الأصوات المطالبة بتحقيق عدالة انتقالية. ضحايا، ونشطاء، وشخصيّات من المجتمع المدني يقولون إنها السبيل الوحيد لكسر دوائر الانتقام في سوريا، لكنّ السلطات تلتزم الصمت.
بعد مجازر آذار/ مارس، وعدوا بلجنة تحقيق، كان من المُفترض إصدار تقرير خلال شهر، تأخّر بالفعل لشهرين. هذا يغذّي شعوراً بالظلم، في الوقت الذي تخرج فيه سوريا من 14 عاماً من الحرب الأهلية، مُثخنة ولكنّ من دون دم.
درج
————————————–
الحقوق والحريات.. فرصة السوريين الأثمن/ وفاء علوش
2025.05.12
لا يخفى على أحد أن المرحلة الحالية في سوريا تتسم بعلوّ أصوات كثيرة وتقاطعها وتنازعها، حتى أن الأمر قد يتعدى ذلك إلى معاداة بعضها البعض الآخر، ومن الممكن القول أننا في خضم فوضى كبيرة من تعالي الأصوات المحقة في مكان والمتصيّدة في مكان آخر، مع غياب واضح للغة العقلانية والموضوعية التي من الممكن أن تنصف المرحلة والسوريين.
من الإنصاف اليوم أن نمتنع عن توصيف السوريين تبعاً لهوياتهم الما قبل وطنية من طائفة ومنطقة وعشيرة وما شابه، أو اعتبار ما يصدر عنا على أنه فعل أصيل يحدد هوياتنا وشخصياتنا، فالسوريون اليوم خارجون من سجن طويل ومظلم بما يجعلنا جميعاً نحتاج وقتاً طويلاً للتعافي.
الأمر الواضح تماماً في ظلّ هذه الفوضى هو عدم وجود ملامح واضحة للمرحلة السياسية في سوريا اليوم، مع وجود مؤشرات متضاربة وإن كان يغلب عليها وعود إيجابية تعطى للسوريين بتغير حال البلاد إلى الأفضل، لكن يرافقها تشكيك كبير من السوريين مرده إلى عدم وجود ثقة بين السلطة والشعب وبين مكونات الشعب بعضهم مع البعض الآخر، ولا يمكن أن يكون مسوّغ ذلك إلا ما زرعه النظام الأسدي من فرقة وجعلنا نحصد نتائجه الكارثية اليوم.
تتصف المرحلة السياسية السورية اليوم بجمود سياسي داخلي تقريباً، على الرغم من التجمعات السياسية والمنتديات التي أُسست أو عادت إلى عملها بعد سقوط النظام الأسدي، غير أن ذلك لم ينعكس حقيقة على الشارع وبقي في إطار نخبوي ولم يشكل لبنة أساسية للبناء عليها سياسياً.
ينكفئ كثير من السوريين عن العمل السياسي لأسباب مختلفة منها وجود أولويات تتعلق بأساسيات الحياة من مأكل ومشرب وتأمين حياة كريمة، بحيث يصبح الانخراط في العمل السياسي رفاهاً ليس في متناول اليد، أما بالنسبة لشريحة كبيرة من السوريين يرى البعض أن مستقبل القرار السياسي السوري مرهون بالتفاهمات الدولية والإقليمية التي لا يؤثر فيها العمل السياسي.
باختصار فإن الظروف المحيطة بالمشهد السياسي السوري اليوم تتشكل من عدة عوامل داخلية وخارجية متشابكة.
تبدو الحياة السياسية معطلة تماماً في سوريا، وسط مخاوف مشروعة وإن لم تكن واقعية من تغيير هوية البلاد وتغيير هواها السياسي والاجتماعي، غير أننا في المقابل لا نجد مشروعاً مضاداً يشكل حاملاً حقيقياً للبلاد في مواجهة مشروع السلطة الذي قد تعارضه شرائح مختلفة من السوريين.
وحتى نكون أكثر واقعية ومن أجل التعامل مع المعطيات السياسية بشكل أكثر عقلانية، فمن الضروري اليوم إذا كنت تعارض السلطة القائمة أن يكون لدينا مشروع بديل، وذلك يتحقق بأن تسعى التجمعات السورية إلى تنظيم نفسها والانخراط في العمل السياسي، ومحاولة الانتشار أفقياً وتقديم مشروع سياسي واضح والخروج من حالة التجاذبات الاجتماعية والسياسية، والعمل على البدء بتأسيس وعي شعبي سياسي واجتماعي ليكون حاملاً حقيقياً لأحلام السوريين.
إن تطلعات السوريين وطموحاتهم لا تنحصر بأن يكونوا جزءاً من السلطة، فمعظم السوريين يريدون تحقيق طموحاتهم التي خرجوا من أجلها سواء كانوا ضمن منظومة السلطة أو خارجها، وإن وجود اختلاف بالآراء هو دليل على حالة صحية، ولكن من الضروري أن تخرج تلك الآراء إلى العلن على هيئة مشاريع حقيقية يستطيع السوريين النظر إليها وتقييمها واختيار الانحياز إلى جانب المعارضة أو إلى جانب السلطة، بناء على وعي سياسي حقيقي لا على انحيازات قبلية غير واعية.
يبدو أن السوريين اليوم أمام استحقاقات ضرورية وأساسية على صعيد الحقوق والحريات على وجه الخصوص، وذلك يتطلب العمل على التمسك بمساحة الحرية الموجودة اليوم وعدم المساومة عليها بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي شكل من أشكال القمع من أجل تمهيد الطريق للتحرك ضمن مساحة حرية آمنة غير قابلة للمساس، وهو أمر غاية في الأهمية من أجل بناء الدولة التي سُرقت منا منذ عقود، ما يعني الدفاع عن الحق في التعبير والتجمع والتنظيم وحرية الإعلام والنشاط السياسي وتشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
لا تستقيم الحرية من دون عدالة، ويكون ذلك بتأسيس دولة قانون قادرة على أن تنظم العمل السياسي والمجتمعي وتمنع الشطط والتحريض والتخريب، والأهم من ذلك تحاسب مرتكبي الجرائم والانتهاكات من الأطراف كلها، فالمواطنون السوريون متساوون أمام القانون مهما اختلف جنسهم أو عرقهم أو طائفتهم والقانون لا يميز بينهم على تلك الأسس، وهذا يعني بالضرورة إصلاح النظام القضائي وتطبيق القانون على الجميع.
ومن نافل القول أن الحياة السياسية لا يمكن أن تستقيم من دون أن تسبقها بذلك الحياة الاقتصادية وتتحسن أوضاع السوريين المعيشية، فالفقر والجوع والبطالة باتت انتهاكًا صريحًا للحق في الحياة الكريمة،
وعلى أن هذه الاستحقاقات تمثل جوهر مطالب الشارع السوري منذ عام 2011 وحتى اليوم، لكنها لا تزال بعيدة عن التحقق بسبب ما يطبق على السوريين من عقوبات عالمية.
إن قابلية السوريين للانخراط في العمل السياسي اليوم تتفاوت حسب المنطقة، الانتماء، والظروف الأمنية، لكن يمكن القول إن كثيراً من السوريين، خاصة من الجيل الشاب، لديهم وعي سياسي كبير واهتمام بالشأن العام، لكنهم فقدوا الثقة بالمسارات السياسية القائمة، وهنا من الواضح أن على النخبة السورية من مثقفين وفنانين وكتاب أن يتولوا مهمة الأخذ بيد السوريين ممن يتخوفون الخوض في هذا المجال بغض النظر عن الرأي السياسي سواء كان مؤيداً للسلطة الجديدة أو معارضاً لها، على أن يكون ذلك ضمن عمل مؤسساتي واضح يحمل مشروعاً حقيقياً ينظم الحالة العامة السورية، كي يتمكن السوريون من الخروج من نفق الاستقطابات والولوج إلى حياة سياسية حقيقية بشكل مهني ومحترف.
وإذا كان على السوريين اليوم أن يناضلوا فإن مساحة الحقوق والحريات هي أهم ما يمكن أن يناضلوا من أجله، ولا يخضعوا فيها لبازار المساومات السياسية، فالاستثمار بالوعي الشعبي السياسي هو استثمار طويل الأمد لا تتحقق نتائجه على الفور، بل تحتاج وقتاً للكمون والتبلور لكنها تكون ذات حصانة لأنها مبنية على وعي حقيقي.
حتى الآن توجد مبادرات مدنية وسياسية صغيرة تنمو ببطء، مجموعات شبابية، حوارات محلية، أحزاب في المنفى، جهود لبناء مجالس محلية أو منتديات سياسية، فالسوريون يملكون الرغبة والقدرة للمشاركة السياسية، لكنهم بحاجة إلى مساحة آمنة وفرص واقعية للتأثير وأجسام سياسية جديرة بالثقة وبيئة قانونية تحترم حقوقهم، خاصة بعد سنوات من القمع السياسي وعدم قدرة الأجسام السياسية التي تأسست خلال الثورة على بناء قاعدة شعبية أو خلق فرص ثقة مع السوريين.
في الحقيقة إن نظام الأسد قد سقط ولكننا ما زلنا نعاني من تبعات الاعتقال الطويل الذي مارسه ونظامه الأمني على عقولنا وأرواحنا طوال عقود، وما زلنا بحاجة إلى فترة من التعافي لتنظيم أنفسنا وقوانا وتحديد مساراتنا السياسية والاجتماعية، لتشكيل مشروع وطني جامع، وشرعية فعلية على الأرض
تلفزيون سوريا
———————————–
إعلان دستوري من ورق/ لمى قنوت
منذ أن وقع أحمد الشرع الإعلان الدستوري في 13 من آذار الماضي، تتوالى انتهاكات نصوصه، وكأنه إعلان دستوري من ورق، وإجراء شكلي لا بد منه، فلا “الدولة” التزمت بحفظ السلم الأهلي، ولم تمنع أشكال الفتن والانقسام والتحريض على العنف كما تنص المادة “7” من الإعلان، بل أتت سياستها بعد جرائم الساحل الطائفية متساهلة مع الخطاب الطائفي والمذهبي المستعر، والذي امتد من العلويين إلى الدروز، حتى الآن، وانخرطت في تقديره وتبريره وزارة الداخلية حين شكرت مسلحين قادوا هجومًا وقتلوا دروزًا في جرمانا واعتبرته غيرة على الدين، وذلك عبر تصريح صحفي صدر عنها في 29 من نيسان الماضي، حين أعربت “عن بالغ شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعًا عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم”، وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي مسيء يهاجم النبي، قيل إنه لشخص من الطائفة الدرزية، وتبين لاحقًا باعتراف الوزارة نفسها عدم صحة نَسبه إلى المُشتبه به.
وكان يفترض بالإدارة الانتقالية محاسبة من شنوا هجومًا مسلحًا كاد أن يؤدي إلى انزلاق البلاد المفككة في حرب أهلية طائفية، فعلى خلفية التسجيل الصوتي المذكور، بدأ التجييش يتصاعد ككرة ثلج، من مشاجرات واشتباك بالأيدي بين بعض طلاب في المدينة الجامعية في حمص وتهديدات طائفية مباشرة أو غير مباشرة أدت إلى مغادرة الطلاب والطالبات الدروز منها والعودة إلى مناطقهم، وانسحب خروجهم الجماعي من جامعاتهم على كل من حمص ودمشق وحلب، وانتقلت التوترات إلى أشرفية صحنايا، وهاجم مسلحون وصفتهم وزارة الداخلية بـ”الخارجين على القانون”، وامتدت الاشتباكات لريف السويداء الغربي، إلى أن تم الاتفاق بين السلطة وقيادات دينية درزية ووجهاء محليين لاحتواء التصعيد.
ومع المطالبات الواسعة والحثيثة بتجريم خطاب الكراهية والخطاب الطائفي من قبل الناشطين الحقوقيين، نساء ورجالًا، يحضُر السؤال: لماذا لا تتجاوب الإدارة الانتقالية مع أهمية هذا المطلب، وخاصة أن قانون العقوبات ينص في المادة “307” على أن “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى مئتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة65 “، أي حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة، وهي “الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها”، ويحرم أيضًا من “الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات”.
وفي العودة إلى انتهاكات نصوص الإعلان الدستوري، كالمادة “8”، “فالدولة” لم تلتزم “بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات”، بل نشر “فريق مكافحة الحريات” أو ما يسمى بـ”الحسبة” مقاطع فيديو يقصون فيه شوارب شبان دروز، ونشر أمنيو الإدارة الانتقالية مقطعًا يعتدون فيه على طلاب من مسيحيي محردة في ريف حماة ويحلقون شعرهم بطريقة مذلة ومصحوبة بإهانات لفظية بسبب جلوسهم مع زميلاتهم، وتتعرض سوريات إلى فصل جندري، وهو تمييز ضد النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن وهو انتهاك للمادة “10”، ويُسأل العديد من المواطنين والمواطنات عن طوائفهم، وعن القرابة التي تربط بين أي رجل وامرأة موجودين معًا، فمثلًا، اعتدت دورية تابعة لجهاز الأمن الداخلي في حمص على الناشط عبد الرحمن كحيل في 2 من أيار الحالي، بسبب طلبهم إثباتًا على أن السيدة التي ترافقه في السيارة هي خطيبته، وتم توقيفهما في فرع الأمن الجنائي، وجرى الاعتداء على كحيل وإهانته، وقبل الإفراج عنه، تم تهديده بأنه في حال نشر خبر اعتقاله، فسوف يتم تلفيق تهمة له بالتهجم على دورية الأمن العام وسجنه لسنوات وتغريمه ماليًا. وبذلك تكون السلطة قد انتهكت أيضًا المادة “12” من الإعلان الدستوري، التي تنص على “حماية الدولة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته”، وتنتهك المادة “18” التي تفيد بدور الدولة في صون كرامة الإنسان، وعدم تعذيبه ماديًا ومعنويًا، عندما يُجبر مُسلحوها مواطنين على تقليد أصوات الحيوانات ويتم تعذيبهم.
تعتمد السلطة الانتقالية في إدارة سوريا المفككة نهجًا يتسم بالإقصاء والمركزية الشديدة والفوضى والاستعانة بالنفير العام والفزعة وشد العصب الطائفي، ونقل العنف الطائفي من مكان لآخر، وتجاهل تجريمه بالقانون، والإصرار على تعيينات بناء على شبكات الولاء وبمنطق المحاصصة على الغنائم، والاعتماد على تعيين مجرمي حرب، كتعيين “أبو حاتم شقرا” قائدًا لـ”الفرقة 86″ بالجيش والعاملة في محافظات كل من دير الزور والرقة والحسكة، والتحايل بتجنيس جهاديين موالين للإدارة كحل للالتفاف على مطالب سورية ودولية بعدم توليهم مناصب قيادية في “الجيش”، وينم كل ذلك عن عدم وجود رغبة حقيقية في بناء عقد اجتماعي ودولة قانون، فالسلطة لا تريد الاحتكام لإعلان دستوري هندسته فكان من ورق.
عنب بلدي
————————-
===============================
عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 13 أيار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
—————————–
هل علينا أن نحذر من الحرب الأهلية؟/ حسام جزماتي
2025.05.12
رفض معظم السوريين وصف ما جرى في وطنهم، خلال السنوات اللاهبة الماضية، بأنه «حرب أهلية». عبّر جمهور الثورة عن هذا في مناسبات عدة، كما صرّح بذلك النظام ومؤيدوه حين كانوا يزعمون أن الاحتجاج عليه مؤامرة خارجية لا مطالب داخلية من أهل البلد.
ولم تأت هذه الحساسية من فراغ. فهناك فارق كبير بين أن تكون ثائراً ضد الظلم والطغيان والاستئثار، سلماً أو حرباً، وبين أن تكون «أحد أطراف النزاع» في صراع محلي. وكذلك بين أن تكون ذراع «الدولة» التي زعمت احتكار الشرعية والدفاع عن وحدة البلاد وأمان العباد، وبين أن تكون عنصراً في قوات عسكرية مدججة مهمتها حماية عرش الأسد واستثمار بعض الشعب ضد بعضه الآخر.
انقضى كل ذلك حين هرب الرأس تاركاً النظام تحت وطأة تكسّر مفاجئ، وقواعده البشرية قيد الذهول، وخصومَه المنهكين في خضم فرح غامر أدار رؤوسهم على غير توقع. وإثر الانتصار السهل، وكلفته البشرية القليلة نسبياً بالقياس إلى المخاوف؛ ساد بين السوريين تفاؤل جارف بمستقبل واعد لبلاد محررة ومزدهرة. لم يتوقع أحد أن المسار سيكون يسيراً معبّداً لكن الجميع ظنوا، أو أمِلوا، أن صفحة «الحرب» قد طويت، وأن الباقي مصاعب هائلة لكنها اقتصادية وإعمارية وخدمية وإدارية وسياسية. ولكن ذلك بدا «مقدوراً عليه» طالما أننا «بالحب بدنا نعمّرها».
قد لا يكون الحب شرطاً لازماً لبناء البلدان، أو استعادة عافيتها، لكن حداً أدنى منه لازم لضمان السلم الضروري لأي تحرك. فضلاً عن أن الكره ليس شعوراً فحسب، بل أرضاً خصبة لقيام «حرب أهلية» موصوفة. واليوم، بعد خمسة أشهر على التحرير، نلاحظ شكاً في موجة التفاؤل التي رافقته، بل تراجعاً كبيراً عنها في بعض البيئات.
في الحقيقة لم يكن بشار الأسد عنواناً لمعسكره من الرافضين للثورة فقط، بل رمزاً للتغيير الذي ينشده آخرون وضعوا الإطاحة به في أول مطالبهم. وبهذا المعنى كان وجوده علامة على أن النزاع سياسي مهما خالطته عصبيات أهلية لطالما استند إليها نظام الأسدين، وتكاتفٍ مضاد استقر تدريجياً على أوساط أغلبية من السنّة العرب. ولذلك كسرت الإطاحة به الأسوار السياسية، الآيلة للسقوط وشبه المزيفة، للصراع الذي بدأ يسلك السبيل الأسهل لوجوده، وهو الطائفية السافرة.
ليس مستغرباً أن تبدأ معالم التشقق بالظهور على الحدود العلوية. فللطائفة دور مركزي في دعم الأسد، وإن لم يكن وحيداً، وبينها أعداد أكبر من المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وهم مطلوبون للمحاكم في حال استوى أمر العدالة الانتقالية المنشودة، أو معرّضون، بشكل عشوائي يخلطهم بغيرهم من المدنيين، لأعمال انتقامية لا تتبين فيها حدود العدل عن الثأر الجماعي. لم يحدث هذا في مطلع آذار المنصرم فقط، بمجازر معروفة، بل قبل ذلك وبعده في حوادث بالمفرّق سوى ما تكثف جملة.
ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن «الحوادث الفردية» لم تطل العلويين فقط، والمرشديين الذين يمازجونهم في الجغرافيا والأصول، بل حصلت في معظم الأراضي السورية وفي بيئات السنّة أنفسهم. فحين عاد الثوار إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، فاتحين، أطلقت الصدور المنتشية سراح ثارات معتقة حبيسة تجاه من كانوا أعوان النظام، بقواته النظامية أو الرديفة (الدفاع الوطني وسواه) أو المخبرين (العواينية). وفي ذاكرة الأرياف، وحارات المدن، سجلٌ لكل من كان مسؤولاً عن اعتقال ثوار عادوا أو بلعتهم الأجهزة الأمنية والسجون، وحساب طويل على التجبر والإهانات والابتزاز والاستيلاء على المنازل والأراضي. ورغم أن هذا ليس مشتهراً على نطاق واسع فإن أعمال القتل المحلي أو الملاحقة أو الوعيد الصريح حدثت بوفرة في حواضن الثورة.
وإذا كان كل ما سبق قد جرى تفهمه، أو فهمه، في سياق غليان الغضب في عروق «أولياء الدم» كما يسمّون، من الناجين أو من ذوي الضحايا خلال الثورة، فإن انتقال الزمجرة الدامية لتهديد بيئات أخرى صار يطرح سؤالاً عن الكراهية مؤخراً. فمن المعروف أن تسجيلاً صوتياً مجهولاً أساء إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، فجّر أحداثاً أوسع تجاه الدروز في جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء، وحتى في حق طلاب جامعيين. وقد سبق لطائفة الموحدين أن ابتعدت، إلى حد غالب، عن المشاركة في «الصراع السوري» قبل سنوات، والتزمت، قدر ما تستطيع، بعدم التحاق أبنائها بالخدمة الإلزامية ما عدا بعض الحالات والشرائح الموالية منها.
وإذا كان العقلاء في الدين، وعلى رأسهم المفتي أسامة الرفاعي، والسياسة، ومنهم ممثلو السلطة الحالية، قد اتفقوا على الضبط والتهدئة؛ فإن أنياب «الفصائل غير المنضبطة» على الأرض وفي المجال العام، أثبتت أن الضواري تتعطش بقوة لنهش جسد الآخر، بعد تكفيره دينياً وتخوينه وطنياً بتعميم توجهات معينة على الجميع، والبحث عن العدو لا الصديق. وقالت هذه الأحداث إن متاريس العقل هشة وإنها تهتز بعنف على أياد كثيرة مضرجة بالدم.
ولا يخفى أن جمهور الكارهين هذا يهمُر بالاتجاه الشمالي الشرقي، ملوحاً للكرد بأن ما يحول بينهم وبين التعرض لسيوفه وفؤوسه هو الاتفاقات التي جرى توقيعها والتي يُنتظر تنفيذها، وفق تفسيرات لم تتضح معالمها، على يد لجان ربما لا تصل إلى نتائج تشبع شهوات سطوة جمهور يرى نفسه في صف موحد حتى الآن.
وبالانطلاق من النقطة الأخيرة فإن شعور الاتحاد متماسك فقط في مواجهة آخر. أما حين يسترخي أهل الدار فلا ضمانة ألا تستيقظ خلافات البيت الواحد، الفصائلية والعشائرية والمناطقية، فتكون الساطور الذي يقصم ظهر البلد.
ولذلك، لا إمام سوى العقل مهما بدا هذا الكلام هرماً. ومهما قيل إنه تنظير لا يلبي غرائز جيل لم يعرف غير الحرب، التي لم تكن أهلية.
تلفزيون سوريا
————————————–
علمانية الطوائف السورية/ ابتسام تريسي
12/5/2025
مصطلحان اثنان نالهما الابتذال أكثر من أيّ شيء مبتذل في الواقع السوري اليوم، الأوّل لوضع العصي بالعجلات، والثاني لتعطيل تحقيقه، وهما العلمانية، والعدالة الانتقالية. فأن تطلب العلمانية من حكومة جاءت من منبت ديني متشدد فهذا يعني أنك لا تريد لهذه الحكومة أن تحقّق أيّ هدف وضعته رغم تخليها (خطابيًا) عن هذا التشدد. أمّا عمليًّا فتحتاج لبعض الوقت؛ كي تحوّل أقوالها لأفعال، هذا الوقت الذي لا يريد المعترضون السوريون أن تحصل عليه.
أمّا العدالة الانتقالية -إن تحققت- فستطول رؤوسًا كثيرة جدًا لا يرغب المعترضون بأن تُحاسب، وكثير منها يُشكّل قوام القوة العسكرية التي حاولت الانقلاب على السلطة الجديدة، بدايةً في الساحل السوري، ثمّ في الجنوب السوري، وهذا يُفسِّر حالة التعنت الشديد الذي يتمسك به “حكمت الهجري” القائد الروحي لجزء من الدروز، والمتبني للمجلس العسكري الذي يريد تحرير دمشق من سلطة الأمر الواقع.
شعارات المعارضة الحديثة
“نريد سوريا علمانية مدنية يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، ويكون للمرأة دورٌ بارز في إعادة بناء الدولة”. شعار سمعناه آلاف المرات من نخب ثقافية بارزة حينًا، ومتواضعة أحيانًا، نادى به مثقفون سنّة يساريون، ومثقفون علويون، ودروز، وأكراد، وامتلأت به مساحات السوشيال ميديا المقروءة، والمسموعة، والمرئية.
لن أتطرق بالشرح لمفهوم العلمانية فهو متاح لكلّ باحث، لكنّي سأذكر أحد الآراء التي رجعت للعصر الأندلسي واستخرجت بذرة الفكرة من ذلك العهد، إذ لما رأى المسيحيون في الأندلس المسلمين وعلاقتهم بربهم -حيث لا واسطة بين المسلم وربه- طالبوا بأن يكونوا مثلهم، وأن يجدوا طريقة يتخلصوا بها من الوسيط بين المسيحي وربه، هذا الوسيط الذي يبيعهم صكوك الغفران، ويفرض عليهم الأتاوات، ويتواطأ مع الملوك لإخضاعهم لسلطة الكنيسة، نمت هذه البذرة، وتكاثرت أغصانها لتغدو في زمن الثورة الفرنسية شعارًا يردده الفرنسيون جميعًا (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس).
مأزق اليساريين السوريين
لقد مرّ زمن طويل جدًا ليقتنع عامة الناس بفكرة العلمانية التي فرضها الشعب عبر ثورة عظيمة بعد أن هضم الفكرة جيدًا. أمّا في سوريا وفي بلادنا العربية عمومًا، فغالبًا لا نجيد إنتاج الأفكار، ونستسهل استيرادها، ونبرّر ذلك بحجة الاستفادة من تجارب الشعوب بغض النظر عن مكونات الخلطة الكيميائية المتباينة بين هذه الشعوب، ونتوقع دائمًا الحصول على النتيجة ذاتها. فاليساري السوري الدرزي ينضوي تحت لواء شيخ العقل، ويمتثل لأوامره، ومن ناحية ثانية يمنع الميراث عن أخته، وإذا تزوجت من غير الطائفة يقتلها، وفي الوقت نفسه يُطالب بدولة علمانية، حتى أنّ الابتذال وصل حدَّ مطالبة شيخ العقل ذاته بدولة علمانية وفي الوقت نفسه يضع على بدلة رجل الأمن الذي عيّنه شعار (يا سلمان) فكيف يطالب الشيخ بفصل الدين عن الدولة، أليس من الأولى أن يعزل نفسه أولاً، ثمّ يتقدم بمثل هذا الطلب؟
العدالة الانتقالية القشة التي يتعلّق بها المجرمون
أمّا عن العدالة الانتقالية فلا ذكر لها عند الشيخ حكمت ومجلسه العسكري وقد وصل به الأمر حد المطالبة بإعادة عناصر الجيش، ودفع رواتب للمجرمين المختبئين في مجلسه العسكري، رغم أنّ بعضهم من كبار المجرمين في العهد البائد.
في الجانب الآخر، وكي لا يبدو الأمر دفاعًا عن طائفة بعينها نجد بعض اليسار السنّي يقع في الحفرة ذاتها إذ نراه يتلعثم عند ميراث أخوته البنات، وقد يستعيد إيمانه بالله إن اقتضت المصلحة ذلك.
أما الجماعة الكردية التي تأوي عصابة قنديل (pkk ) فالأمر لا يتوقف عند هذه التناقضات، بل يتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك فاختطاف القاصرات والأطفال وتجنيدهم عسكريًا في خدمة حزب العمال الكردستاني يُعد جريمة الجرائم التي لا يقبل بها دين أو نظام علماني على وجه الأرض، ومع ذلك يريدون سوريا علمانية.
الأسد فكرة والفكرة لا تموت!
هذا الواقع الأسود الذي تعيشه سوريا اليوم، هو نتاج طبيعي لما أفرزه الاستبداد الأسدي الذي جعل من السهولة بمكان ارتباط بعض المكونات بأجندات خارجية تلعب في الملف السوري كما تشاء مصالحها، يُساعد في ذلك مجمل الأخطاء التي وقعت فيها السلطة الجديدة والتي تحاول جاهدة تسوية النزاعات بطرق سلمية قد تضطرها لتنازلات هي بغنى عنها، خاصة وأنّها تعلم جيدًا أنها مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي بدستور يرضى عنه العالم (المتحضر) قبل الشعب السوري الذي ما زال ينتظر العدالة الانتقالية، ورفع العقوبات الأمريكية عنه؛ كي تبرأ جراحه.
وعلى هذا الأساس ينظر السوريون المعتدلون إلى النشاط الخارجي للرئيس الشرع نظرة أمل لإيجاد حلّ للوضع السوري في أقرب وقت، بينما يحاول الطائفيون العلمانيون التغطية عليه بنشر قصص الخطف والاضطهاد من قبل الدولة الإرهابية.
فقد طلب مشايخ الدروز من العائلات الدرزية إعادة أبنائهم من جميع الجامعات السورية إلى السويداء، وانتشرت الفيديوهات التي علّق عليها الإعلامي الدرزي المعروف بمواقفه المُشرّفة من الثورة السورية منذ انطلاق شرارتها الأولى، قائلًا: “الرحيل الجماعي لطلاب السويداء من جامعاتهم في المحافظات السورية -بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم على خلفية انتمائهم الديني-خبرٌ لن تجد له أثرًا في الإعلام المسمّى وطنيًّا! يا لعارنا!”. وللأسف لم يكن ماهر شرف الدين وحده الذي تبنّى التحريض الطائفي علنًا، بل كثر من مثقفي وإعلامي الطائفة.
وعلى الطرف الآخر ارتفعت نسبة شيطنة السنة من قبل العلويين الذين ركبوا ترند “السبي” فراحوا ينشرون صورًا لفتيات مخطوفات على أنّهنّ سبايا “الأمن العام” وأنّ إدلب صارت سوقًا للسبايا. ويتبين بعد أيام أنّ الخبر كاذب، وتظهر الفتيات في فيديوهات مسجلة ينفين تعرضهنّ للخطف، لكنّ المحرضين لا يتوقفون، ويستمرون في تسويق أوهامهم التي يتمنّون لو كانت حقيقة؛ كي يستطيعوا الطعن في الحكومة وتكريس صفة الإرهاب عليها.
المصدر : الجزيرة مباشر
———————————
التحريض الطائفي وخطاب الكراهية.. هل نحن المدانون؟/ جمال الشوفي
2025.05.13
تشهد الساحة الكلامية والخطابية السورية اليوم تزايداً في مؤشرات خطرها على النسيج الوطني. إذ لا يكاد يمضي يوم إلا وعديد الأحداث التي نتابعها ويتفاعل معها رصيد كبير من السوريين بطريقة تنحرف بعيداً عن تضحيات الثورة وعمرها الطويل. فانتشار خطابات التحريض الطائفية المتبادلة واتساع دائرة نفي ولجم المختلف رأياً او قولاً، وازدياد وتكرار معدلات الرفض المطلق والتي تتساوى مع خطاب الكراهية باتت لا تبشر بالخير أبداً، ولربما بكوارث كبرى. فإن كنت أفترض أن انفتاح الفضاء العام أم السوريين بعد قمع متراكم لعقود هو الرائز والمحرك لاستعار حمى الفوضى الثقافية والفكرية والسياسية الذي تعيشها سوريا اليوم كمرحلة أشبه ما تكون بالطبيعية في مراحل ما بعد تغير وسقوط الأنظمة الدكتاتورية كما شهدناها تاريخياً، لكنها بذات الوقت تضعنا جميعاً أمام مسؤوليات واستحقاقات المرحلة الحالية وأخطارها وسبل الإشارة لها وتداركها قبل فوات الأوان.
التحريض الطائفي وخطاب الكراهية هي الوجه الأخطر على النسيج السوري اليوم، وتتجلى أبرز سماته بـ:
– تقسيم الشعب السوري لموال وخائن، خائن وليس معارض! ومن أي الأطراف عامة.
– التعميم الجزافي وتجريم طائفة بأكملها: سنة متطرفون، دروز انفصاليون، علويون فلول….
– تزايد الإشاعات والتضليل الإعلامي خاصة المتداولة على السوشيال ميديا. فإن كانت كثير من الفيديوهات المنشورة صحيحة لكن يقابلها فبركات عديدة غير صحيحة، وهذا مجال للاختلاط والشك بالحقائق.
– تبادل التهم والتكذيب والشتائم واستسهال الإساءة.
– تكفير المختلف سياسياً ودينياً.
– زيادة مؤشرات التقوقع الطائفي.
– انخفاض صوت العقلاء وتهميش أقوالهم، فرغم كل ما يتكلمون به بتهدئة النفوس وتخفيف حدة الغلواء السائدة، لكن مطحنة التحريض والتجريم لا تتح لهذه الأصوات بالسماع…
قد يقول أحدهم وكأنك لا ترى من الكوب إلا نصفه ولا تشير إلا للسلبيات، لأكرر القول إن رؤية الواقع ومعاينته جزء أساسي من الحقيقة أولاً، ومن ثم العلاج ثانياً، فالتشخيص الصحيح جزء من العلاج الصحيح حتى وإن كان صادماً والعكس صحيح أيضاً. فالاكتفاء بالتوصيف السياسي هام لكنه غير كاف اليوم إذ باتت الواقع تتجاوزه للمحتوى والمضمون الثقافي. ما يجعل الوجدان السوري وقيمه الوطنية وتنوعه العام وارتباطه القوي تاريخياً ومصيراً في أهم درجات اختباره اليوم. هو موجود ويحاول جهده نبذ خطاب الكراهية والتحريض الطائفي المقيت، لكن موجة الأخير عالية وجب الوقوف عندها. وقد يقول قائل إنها موجة وإن علت لكنها زائلة ولن تدوم. رغم أني أتمنى ذلك، لكن ما بات يُرقب على مساحة الساحة السورية هو انكشاف لساحة ثقافية دفينة تتجاوز
الفعل السياسي الإجرائي، وهذا الاختبار والتحدي الأكبر. إضافة لذلك، أجد نفسي وأنا أدون هذه الجمل مدان في نفسي وفي ثقافتي، إذ لطالما كنا ولازلنا نحتكم لثقافة المحبة والخير والسلام، وندعو للحوار والانفتاح وتقريب المسافات فكيف وصلنا لهنا؟ ومدان لأنني أكتب عن الكراهية كثقافة وخطاب وهذا خطر كبير أرجو أن أكون مخطئ بتقديره.
أجل، ثمة ثقافة تنتشر كالنار في الحطب، حطب الذات السورية التي لم تستفق بعد من حجم مظلومياتها الثقيلة. فحجم التركة السورية من قتل وعنف وصراع دامي طال البشر والحجر والأطفال وكل صنوف الحياة ليس بالسهولة تجاوزه بنصر سياسي وتغيير سلطة وإسقاط نظام. بل تبدأ النفس البشرية البحث عما يؤمن لها طاقتها من الاستقرار وعنونة الوجود. وما نلاحظه اليوم هو استعار حمى إثبات الوجود بالأحقية المطلقة سواء ممن كانوا مسحوقين من أبناء الثورة وباتوا اليوم منتصرون، ما يجعلهم يستميتون لعدم تقبل أي رأي أو نقد مختلف، أو من الجهات الأخرى التي كانت مسالمة وتعيش في ظل النظام السابق موالية كانت له أو معارضة بصمت، إذ باتت تدافع عن وجودها حين تؤخذ بغرة غيرها بوصفها فلول! في حين المستفيد من هذه المشاهد المتكررة والمتوالية هم الساعون بكل جهودهم التقنية والإعلامية لهدم الاستقرار الممكن في سوريا وهدم تجربة الخلاص من نظام القهر والقمع البائد مولد كل ما نحيا من كوارث. وتقرير الوكالة البريطانية للأخبار (BBC) الذي يكشف أن التحريض الطائفي وبث خطاب الكراهية تقوم به أيادٍ خارجية تسعى لتأزيم الوضع السوري وتفتيته. والمشكلة التي يجب علاجها قبل تفاقهما هو استجابة الشارع الشعبي خلفها سواء بالموافقة الكلية أو الرفض الكلي، ما يجعل غياب العقل والتعقل والتدقيق فيما يقال أو يشاع هو المهيمن على الساحة السورية وسعرات الكراهية وثقافتها بتزايد.
الإشكال البارز في خضم هذه التواترات وما يرافقها من عنف محلي باستخدام السلاج هو تغييب وإدانة صوت العقل وثقافة السلام والبناء. أجل بتنا مدانون من ضفتي خطاب التحريض والكراهية المتبادل، مدانون لكون العاقل منا أراد ويريد مغايرة الواقع والخروج من ثقافة القهر والاعتقال والاضطهاد السياسي ونتائجها الكارثية لثقافة الحوار والعدالة بعيداً عن الانتقام، لثقافة الكلمة بعيداً عن السلاح.
اليوم مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي مسؤولية سورية ثقافية، مسؤولية العقلانية والنخب السورية من جهة، ومسؤولية السلطة واعلامها في الابتعاد عن التحييز والتجيير وكشف الحقائق للعلن بوضوح، ومسؤولية الحكومة بتعدد وظائفها العمل على السلم الأهلي وفتح بوابات الجوار المحلية الأهلية والاجتماعية بين المختلفين في الآراء توصيفاً أو تشكيكاً، وصولاً لحوار الأديان والطوائف على اختلاف عديدها بالجهة المقابلة. وليس فقط بل أيضاً إصدار القوانين لصارمة بمحاسبة كل من يبث خطاب الكراهية والتفرقة الدينية والإساءة للرموز الدينية والتعايش السلمي وفقاً للقانون وبمرجعية القضاء والعدالة، تقليصاً لفكرة الانتقام وتهويناً على الأنفس والحد من الغلو السياسي والديني المتمظهر ثقافياً بسموم الكراهية والتحريض الطائفي.
حملت ثورة السوريين شتى صنوف التغيرات في الواقع المجتمعي والفكري والسياسي، شتى صنوف التناقضات والاختلافات والتباينات! وحتى لا نمارس ذات حكم القيمة السلبية ومحمولها السيء، أدرك أن مسيرة السوريين قد تداخلت في مساراتهم شتى صنوف الجريمة والتي لا يمكن تحميلها لجهة من دون غيرها؛ لكن من حق الجيل الذي عاصر الثورة، جيل القرن الواحد والعشرين وقد بلغ سن الشباب، جيل الانفتاح والتحولات الكبرى من حقه أن نكاشفه بما نحن عليه، بما كنا وكيف صرنا وكيف علينا أن نعمل معاً لتجاوز تحديات الواقع الحالي سياسياً وثقافياً. ولنوصف حينها بجيل الإدانة، لأننا ونحن نعاند مسار الانحدار هذا، علينا تحمل تركات الواقع النفسي والقهري الذي عاشه السوريين ولازال مستمراً لليوم وإن تغيرت المعادلة بين ظالم ومظلوم. ولنكن مدانون حين نقول أن كل السوريون مظلومون ما لم تتحقق العدالة والمساواة وما لم ينصف القضاء جماع المظالم السورية بأهلية القانون واحترام الاختلاف والدفاع عن السلم والسلام والأمان كأساس لبناء دولة الحق والقانون. وهذه مسؤولية جماعية متبادلة بين الحكومة وسلطاتها العامة وبين الشعب وتنويعاتها النفسية والثقافية.
نحن جيل الإدانة وجيل الحرب الذي يخسر به الجميع حتى المنتصر، ووجب علينا المكاشفة، النقد، البحث مرة أخرى في أحقية الوجود واهميته كقيمة جمعية يشارك فيها الجميع في تحقيق قيمة الذات الكلية. والذات الكلية هوية عامة وتعاقد على فعل الوجوب والوجود، أهم ميزاته تحقيق وتقدير الذوات للجميع من دون محاصصة أو خيلاء أو واسطة. ولن نكون ملامون إذا ما تمكنا من تدارك الانحدار الذي نعيشه وعلاج تركة الخيبات والآلام والحسرات وعدم تكرارها مرة أخرى.
لم أرغب بالدخول بتحليل سياسي في هذا الصدد إلا لأنني أتلمس ضعفه أمام الإشارة للواقع الثقافي السائد وأخطاره الجسام، ولأكن مدان بهذا أيضاً، فسوريا التي نريد وإن كانت بوابة ولوجها سياسية لكن افتراش واقعها وحياتها ثقافية واسعة تحتاج العناية والاشارة والدلالة.
تلفزيون سوريا
—————————
فلول في ثياب الأمن العام.. من يفكك الألغام الاجتماعية من مخلفات الأسد؟/ عبد القادر المنلا
2025.05.13
بعد هروب بشار الأسد، اعتقد السوريون أن تلك الصفحة السوداء في تاريخ سوريا قد طويت إلى الأبد، وأن سوريا الجديدة قد بدأت تلملم جراحها وتكنس تاريخ تلك العائلة التي دمرت سوريا وشوهت نسيجها الوطني، تلك المرحلة الطويلة التي ابتدأت مع تسلط الأب على السلطة، ولم تنته إلا بعد أن أكمل الابن تدمير سوريا وتمزيقها..
وبعد أقل من شهر على التحرير، اكتشف السوريون مخلفات الأسد التي اتضح أن تنظيفها يحتاج لفترة أطول مما كان متوقعاً، فبالإضافة إلى كميات الدمار والخراب والانتهاكات الجسيمة والمجازر الجماعية والمعوقين والمعتقلات وما كان يحدث فيها وملايين المهجرين وسرقة مقدرات البلد وحجم الفقر والحاجة الذي وضع فيه النظام السابق السوريين قبل وبعد رحيله، فلقد تم اكتشاف كمية كبيرة جداً من الألغام المنتشرة في كل مكان في سوريا، ولكن تلك الألغام لا تتوقف عند الألغام الأرضية المادية المتعارف عليها، فثمة نوع آخر أشد خطراً وفتكاً بالمجتمع السوري وهو الألغام الفكرية والاجتماعية والمتمثلة في الزراعة المتعمدة للطائفية وهي الألغام التي بدأت تنفجر تباعاً وتضع السوريين في مواجهة خطر قد يقضي على حلمهم في بناء دولتهم الجديدة.
بدأت أول تلك الألغام تتفجر بظهور الفلول التي قامت بعمليات لم تستهدف الأمن العام فقط ولا حلم السوريين وحسب، بل استهدفت بالدرجة الأولى الطائفة العلوية التي كان معظم أبنائها متوافقين مع سوريا الجديدة وفرحين بالتخلص من الأسد مثلهم مثل باقي المكونات السورية، راهن الفلول على رد فعل الدولة الطبيعي والذي تمثل في حملة عسكرية مضادة انفلتت في بعض الأحيان لتتحول إلى حالة انتقام من أبناء الطائفة، وهو بالضبط ما كان هدف الفلول للتأسيس لمرحلة من الفوضى وإثبات الاتهامات على الدولة الجديدة على أنها تستهدف طائفة محددة، الأمر الذي أنهى شهر العسل الذي عاشه الساحل السوري، وأدى إلى تهديد السلم الأهلي والذي يكاد اليوم أن يتبدد إن لم يتم التعامل معه بشكل احترافي وموضوعي ونزع تلك الألغام سريعاً..
ورغم أن الجرائم التي ارتكبت ضد الأبرياء والانتهاكات التي حدثت في الساحل تم نسبها إلى فصائل متشددة، وأفراد خارجين على القانون، إلا أن ذلك لا ينفي مشاركة الفلول فيها سواء بالمشاركة الفعلية أو من خلال التسبب فيها، غير أن كثير من الروايات التي تواردت -وهذه لا يمكن إثباتها أو نفيها حتى الآن- تؤكد مساهمة الفلول في قتل أبرياء من الطائفة العلوية ونسبها إلى تلك الفصائل للمساهمة في زيادة صب الزيت على النار، ثم تطورت آليات عمل الفلول حيث راحوا يرتدون ملابس الأمن العام ويرتكبون المجازر، وهو ما يؤكده قتل شخصيات علوية كانت معروفة بمعارضتها لنظام الأسد حيث تضرب الفلول عصفورين بحجر من خلال ارتكاب تلك الجرائم، أولها الانتقام من معارضي الأسد من الطائفة العلوية، وثانيها اتهام الدولة بهم، لأن تلك الطريقة وحدها هي ما يضمن تأليب السوريين ضد القيادة الجديدة ولا سيما أن الطابع الديني والمتطرف أحياناً الذي أبدته بعض الفصائل سيسهم بشكل كبير في إقناع الرأي العام المحلي والدولي بصحة نسبة تلك الانتهاكات إلى الدولة..
هذا لا ينفي بالتأكيد الجرائم التي ارتكبها أفراد وفصائل محسوبون على الحكومة الجديدة وعلى الأمن العام ووزارة الدفاع، ولكن الفلول اتبعت أيضاً ذات طريقة النظام البائد وأساليبه الشيطانية في معالجة أزماته، ففي بداية الثورة السورية وقبل أن يحمل أحد من السوريين السلاح لم يتردد نظام الأسد بقتل كثير من عناصره وجنوده وحتى بعض ضباطه، ليثبت أن ما كان يحدث ليس ثورة وإنما عمليات إجرامية تقوم بها مجموعات مسلحة إرهابية تقتل الأبرياء، وتبدو الفلول اليوم بحاجة لذات الذرائع التي اعتمدها النظام لتشويه الثورة حينها لكي تتمكن من تشويه صورة الحكومة الجديدة اليوم، فعقلية الفلول لا تختلف عن عقلية نظامهم وقدراتهم الإجرامية لا تقل عن قدراته ومستوى الانحطاط الأخلاقي لديهم لا يقل عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لنظامهم البائد، بل ربما تفوقوا عليه في الانحطاط بعد أن فقدوا السلطة وفقدوا أيضاً بوصلتهم الإجرامية التي كانت تستهدف المعارضين للأسد بشكل رئيسي وأضحت اليوم ترتكب الجرائم بشكل عشوائي ولا تتردد في قتل أفراد من الطائفة العلوية، فبهذه الطريقة وحدها تضمن إزعاج الحكومة الحالية وقضّ مضاجعها واستدراجها إلى موقع الدفاع عن النفس..
ومع الإقرار باحتمالات قابلية كل ما سبق ليكون حقيقة، إلا أنه ليس الحقيقة الوحيدة، فثمة اليوم فئات عديدة من الفلول الذين يعملون لصالح الأسد الفارّ من دون قصد، وربما يعتقدون أنهم يعملون لصالح الحكومة السورية ولصالح الدولة، وأول هؤلاء هم العناصر المحسوبة على الدولة الجديدة والتي ترتكب جرائم قتل بحق الأبرياء من الطوائف الأخرى ظناً منها أنها تسهم في بناء الدولة من خلال التخلص من أفراد لا ينتمون لذات العقيدة التي ينتمون هم لها، وهي أكبر خدمة تقدم للفلول وللمتربصين من الحريصين على عرقلة مسار الدولة السورية وإفشالها، أو أولئك الذين يجرّمون طائفة كاملة فقط لكون الأسد ينتسب إليها وهؤلاء يقومون بالقتل وكأنه فعل وطني، وهذا سلوك لا يختلف عن سلوك الفلول في شيء لا من حيث الفعل نفسه ولا من حيث النتائج المترتبة عليه..
في ذات السياق، يلعب كثيرون من مؤيدي الحكومة الجديدة دوراً لا يقل عن دور الفلول في تنزيههم للفصائل التي ترتكب الانتهاكات وإنكارهم لأي خطأ ترتكبه الحكومة بل وتحويله إلى فضائل، سواء كان ذلك بسبب الانتماء الطائفي أو بسبب الحماس الزائد للدولة الجديدة وحكومتها أو بسبب الجهل والتشدد، وهي ذات طريقة أتباع النظام السابق في تقديسهم للأسد وإنكار جرائمه، في حين إن مساعدة الحكومة الجديدة والوقوف إلى جانبها في سعيها لبناء الدولة يتطلب الاعتراف بأخطائها والحرص على نقدها وعدم تبرير أي خطأ يتم ارتكابه لأن ذلك سيؤدي إلى تراكم الغش والخديعة وتوسيع الهوة بين مكونات الشعب السوري والتي تحاول الحكومة أن ترممها، على الأقل في حين يتعلق بالموقف الرسمي والتصريحات العلنية..
النوع الآخر من الفلول يتمثل في أولئك الداعمين للإشاعات والذين تهمهم الشائعة أكثر مما تهمهم الحقائق، وهؤلاء موجودون في كل المكونات، حيث تلتقي الشائعة مع رغباتهم فيسعون بكل طاقتهم إلى نفي الحقائق وإحلال الشائعات مكانها حتى لو تم دحض الشائعة، وهؤلاء يدعمون مشروع الفلول بقوة بل ويتحولون إلى جزء منه في حين هم يعتقدون أنهم يحاربون ذلك المشروع..
منذ أيام أصدر مفتي سوريا فتوى بتحريم الدم السوري، وبالأمس صدر قرار هام للغاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتجريم كل الأصوات التي تحرض على الكراهية ومساءلة أصحابها مدنياً وجزائياً وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وهي خطوات على طريق لجم الطائفية المستشرية والحد منها، ولكن المعركة لا تزال طويلة ومعقدة لأن الدمار النفسي والاجتماعي الذي خلفه نظام الأسد لا يزال يتحكم بكثيرين من أبناء الشعب السوري من كافة الطوائف والمكونات، وهنا تبدو المراهنة على نشر الوعي هي الطريق الأمثل لحماية الشعب السوري من سرطان الكراهية وأمراض الطائفية الخبيثة..
لقد آن الأوان لتفعيل القوة الناعمة، وهي قوة الثقافة والتي لا تزال حتى الآن شبه معطلة نظراً للمخاض العسير الذي تمر به البلاد، غير أن الالتفات إلى قوة الفعل الثقافي وقدرته على المساهمة في ترميم المرحلة يبدو اليوم من أهم الأسلحة وأكثرها فاعلية، وهنا يمكن استغلال المسارح والمراكز الثقافية لإقامة نشاطات وفعاليات أدبية وفنية وفكرية تنشر مفهوم المواطنة وتضعه فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهو طريق أساسي ممهد ويساعد بشكل استثنائي في الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد، والخروج من دوامة الإشاعات أيضاً، كما أنه الضامن لمشروع السلم الأهلي وأحد مرتكزاته الأساسية والذي لا يمكن أن يتحقق من خلال لجان تحقيق في الجرائم فقط، ولا في قوانين معينة، بل في نشر الوعي الذي يحتاجه المجتمع السوري ليتمكن من استئصال الأمراض المزمنة، ونزع الألغام الاجتماعية التي تركها الأسد على امتداد الأرض السورية، وبغير ذلك سيبقى من السهل على الفلول من كل الأنواع السابقة التي تم ذكرها ارتداء ملابس الأمن العام، وستبقى قدرات الشائعات أكبر من قدرات الحقائق..
——————————–
درّاجات الموت وجرائم القتل في حمص السورية/ وداد سلوم
13 مايو 2025
في عصر كل يوم وقبل أن ترخي الظلمة ستارها كاملاً على المكان تنشط حركة الدرّاجات النارية في عدة أحياء في مدينة حمص، باتت مسكونة بالأشباح والخطر، إذ يدخل الناس عصراً ولا يعودون للخروج، تقفل الأبواب، وتوصد جيداً حتى الصباح، انتهى عهد الزيارات والسهرات بين الأقارب والجيران والأصدقاء، حتى الشرفات في البيوت، يترصدها القتل كما الشوارع ذاتها.
تتحرّك الدراجات في كل الاتجاهات من دون خوف، بينما ينشر صوتها الخوف في قلوب الناس المترقبة. إنه مؤشّر لتحرّك الموت وتجواله العلني، بعد حين قد تسمع طلقات متفرّقة ثم يتم إعلان الخبر عبر مجموعات واتس أب وصفحات فيسبوك عن أخبار القتل، الذي تناول عائلات كاملة بينها الأطفال والنساء. إنه التسلسل المعتاد، الذي تجري وفقه الأحداث، ما خطف الأبصار عن حوادث الخطف التي تنتهي أيضاً بالقتل من دون معرفة الجاني.
لم تتوقّف الجرائم عند طائفة محدّدة، فهذه الأحياء ذات طابع مختلط لكن الغالبية من الطائفة العلوية. إذ كان هناك ضحايا من الطائفة المرشدية ومن السنة، ولكن الأغلبية كانت بشكل طبيعي من الطائفة العلوية.
في 3 إبريل/ نيسان الماضي، كانت الأم تسير مع طفليها في الشارع عائدة إلى المنزل في حي كرم اللوز، والعائلة أصلاً جرى تهجيرها من حي النازحين، مرّت قربهم درّاجة نارية عليها شابان، رمى أحدهما قنبلة (قيل أنها صوتية) على العائلة، ما أسفر عن قتل الطفل حيدر سليمان (12 عاما) واصيبت الأم والأخ الأصغر بجروح. كان استخدام قنبلة أمراً مثيراً ليس فقط للرعب والاعلام بل أيضاً مثيرا للاستفزاز لحجم الاستهتار بالوضع الأمني، وهذا بالذات ربما سبب تخفيض عتبة التصعيد زمنياً او بوسيلة القتل، فالجريمة الثانية وقعت بعد أسبوعين وفي الحي نفسه ولكن استبدلت القنبلة بإطلاق الرصاص. إذ أطلق شخصان على درّاجة نارّية في 19 إبريل/ نيسان النار على أم وابنتيها التوأمين (19 عاماً) في وقت عودتهن من بيت الجد توفيت الأم وابنتاها أمام نظر الأب.
لم يتوقف ذلك على وقتٍ معين، ففي حين أن الجريمتين المذكورتين كانتا في نهاية النهار وبدء الظلام، إلا أن بعض الجرائم كانت تتم أيضاً في وضح النهار؛ مثلاً في حي السبيل أقدم شخصان يستقلان درّاجة نارّية على إطلاق النار وقتل الشاب سليمان عيسى الحوراني في محله بتاريخ 25/4/2025. وكانت قد حدثت حادثة شبيهة بذلك في وقت سابق باستهداف شابين أمام أحد المحال التجارية أسفر عن وفاة أحدهما في حي المهاجرين بحمص.
وأمام الأصوات المتصاعدة التي تتهم الجهات الرسمية بإغماض العين عما تفعله هذه الدرّاجات، التي تنوعت أعمالها بين القتل ورمي القنابل الصوتية في بعض الشوارع من دون هدف سوى إحداث الرعب من حين إلى آخر. أمام هذا، صدرت عدة توجيهات وقرارات بمنع مرور هذه الدرّاجات بعد الخامسة مساء في الأحياء السكنية، وتمّت مصادرة العديد منها غير المرخصة. وللأسف، يبدو أن آلية تطبيق القرارات كانت غير فعالة، وربما غير دقيقة، حتى أن بعض هذه الدرّاجات هاجمت الأمن العام في أحد الحواجز على خلفيةٍ بقيت غامضة وغير مفهومة. فكثيراً ما كان الأشخاص على هذه الدراجات ملثمين ويرتدون اللباس المموه حتى اختلطت صورتهم لدى الناس ولم يعد أحد قادراً على التمييز بين المجرم والمنتقم بشكل شخصي وبين أفراد تنتمي لقوى تابعة للحكومة. إلى درجة أن ما حدث في 22 إبريل/ نيسان كان لافتاً، إذ كانت الجريمة، حسب ما تداولته المواقع عن شهود عيان، أن الدرّاجة النارّية توقفت وترجل أحد الراكبين عليها ومشى باتجاه الضحية فواز رجب مع ابنة أخيه ( من تدمر يقطن في ضاحية الوليد)، اقترب القاتل منهما، ثم أطلق النار ببرود وعاد إلى الدرّاجة، حيث ينتظره شريكه، صعد وانطلقا.
تعدّى الاعتداء على المواطنين في الشوارع، وانتقل إلى البيوت، ففي الشهر الماضي (إبريل/ نيسان) أطلق أحدهم النار على مفيد سليمان وأخيه معين سليمان وزوجته لينا ديوب وذلك من شباك المنزل المفتوح في حي كرم الزيتون. وفي الـ4 من الشهر الحالي (مايو/ أيار) أطلق ملثمان يستقلان دراجة نارية، الرصاص على سحر إبراهيم وزوجها في شرفة منزلهما الأرضي، تعمل سحر(35 عاماً) مدرّسة لغة فرنسية ولديها طفلان، توفيت إثر إصابتها البليغة.
ومن استخدام البارودة الروسية إلى استخدام المسدسات وأحياناً بكاتم صوت. إذ قتل في اليوم نفسه شاب وهو عائد إلى منزله في جانب آخر من الحي. وبعد يوم، جرى اطلاق النار على عائلة في شارع الأهرام، الأم توفيت مباشرة وإحدى ابنتيها لحقت بها في اليوم الثاني بعد إصابة في الرأس. ذكر أن الجريمة كانت على خلفية تهديد العائلة للخروج من منزلها بغرض الاستيلاء عليه.
تعيش حمص أياماً صعبة على الصعيد الأمني، الذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة الناس وللسلم الأهلي. إذ يجري اقتناص الأشخاص والعائلات وكأنهم العصافير من دون أدنى خوف من الإمساك بهم او المحاسبة، رغم السعي الحثيث إلى إعادة هذه الأحياء إلى الحياة. تشكل الجرائم المتتالية حاجزاً بين هذه الأحياء والانخراط في الحياة العامة أو النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم في مركز المدينة. ولا يخفى على أحد أن الخطف مسألة تشكل المانع الأكبر لدى الشباب والشابات، وهكذا تعود هذه الاحياء المستهدفة إلى التقوقع والانعزال.
بدأت الحوادث متباعدة، ثم صارت متقاربة إلى درجة أن تقع حادثتا قتل في ليلة واحدة أو في ليلتين متتاليتين، ويبقى السؤال مشرعاً من أين تأتي هذه الدراجات، وما السر في ظهورها واختفائها ناشرة الموت والرعب في الطرقات والبيوت من دون القبض على أحد الجناة؟ وماذا وراء اصطياد الناس العزّل، أهو القصاص الفردي والثأر والانتقام؟ أم هي رغبة في تهجير سكان هذه الأحياء عبر إثارة الرعب والخوف والإذلال؟ أم أنه إحراج للحكومة ومحاولة إظهارها بمظهر غير القادر على إدارة الحياة اليومية لمواطنيها؟ أما عن السلاح فهو متوفر على صفحات النت للتجارة التي تثير أسئلة كثيرة.
وفي كل الحالات، بين الضحايا أطفال ونساء يقتلون ظلماً ومن دون ذنب. وضحايا تدفع ثمن جريمة آخرين أو ثمن جرائم النظام البائد لمجرد انتمائها لطائفته، فأين القضاء الذي عليه أن يحمي المواطنين على أرض بلدهم، وأن يقف على مسافة واحدة من كل المواطنين، وعدم ترك الأمر للدوافع الشخصية بتحقيق العدالة واسترداد الحقوق وعدم التعدّي على حقوق الأبرياء؟
لم تعد حالات فردية، بل هي جريمة مستمرة. على الحكومة أن تدفع باتجاه إيقافها حتى تستوعب الوضع في حمص التي يقول عنها المراقبون منذ سقوط نظام الأسد المجرم إنها صمام الأمان لسورية كلها.
———————-
نعمة الطوائف ونقمة الطائفية: في العقد الاجتماعي وقلق الهوية السورية/ محمد خالد شاكر
13 مايو 2025
لم يشهد التاريخ السوري فرزاً دوغمائياً نكائياً طائفياً أكثر مما يشهده اليوم؛ فلم تعد الطائفية في سورية خطاباً شعبوياً على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بقدر ما تحولت إلى حالة مرعبة، أصبحت تتسلّل رويداً رويداً إلى الخطاب السوري، إعلامياً، وثقافياً، وسياسياً.
قبل تأصيل ظاهرة تصاعد الخطاب الطائفي بسبب عدم تبلور الهوية السورية، تاريخياً، في إطار عقد اجتماعي يعكس تعدّدية المجتمع؛ لابد من التعريج على أسبابه المباشرة التي ولدت من رحم صراع دموي ومدمّر، فالتحوّلات القسرية التي طرأت على المجتمع السوري خلال سنوات الحرب 2012- 2024، دفعت بالشخصية السورية المذعورة إلى الانكفاء على خصوصيّتها ردّ فعل للواقع المحتدم؛ فتحول المجتمع السوري المسالم والمتآلف إلى خاصرة رخوة من الخوف والانقسام والتشظي طائفياً، وإثنياً، ومذهبياً، وسياسياً، وعسكرياً.
وكما تفرض التعدّدية السياسية نفسها ميزة لتعزيز قيم العدالة والحكم الرشيد في مواجهة الاستبداد، تشكل المجتمعات المتعددة طائفياً وإثنياً إحدى ميزات المجتمعات المتحضرة اليوم، وذلك من خلال حوكمة مؤسّساتها، التي تضطلع بصهر الهويات الفرعية في بوتقة الدولة الوطنية، فكلما أحسنت السلطات الحاكمة إدارة التنوّع والاختلاف، نجحت في إدارة التنوّع ونقلته من تعدّدية الصراع إلى تعددية التوازن والتكامل.
تواجه المؤسّسة الثقافية السورية اليوم المهمّة الأكثر إلحاحاً في طريق بناء الدولة السورية، وذلك في قدرتها على مواجهة الخطاب الطائفي الشعبوي المنفلت، وانتشال العقلية السورية من إرثها الثقيل المحمّل بعقود من القهر والخوف والموت والاستبداد.
لقد أصبحت الطائفية وجبة شهية مادتها الكراهية والتشفي والانتقام، فطفت على السطح مفردات الضد من الوطنية، كتسفيه الاعتقاد والخصوصية الدينية، والحديث عن تاريخية هذه الطائفة، وغموض تلك، ووصف هذه الطائفة بالغلو والكفر؛ يؤازرها سرديات لي عنق التاريخ من خلال الحديث عن علاقة هذه الطائفة بالمحتل الفرنسي، وربط تلك الطائفة بالنظام البائد، والأخرى بإسرائيل، قابله انكفاء على الخصوصية، أدّى إلى تصاعد حمّى الهويات الفرعية؛ وكأن السوريين يتجهزون لمرحلة ملوك الطوائف، في مرحلة أحوج ما يكونون فيها إلى وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة السورية، وبلورة هويتها الوطنية الجامعة.
يرى جان جاك روسو ( 1712- 1778) “أن البشر مسالمون بطبيعتهم، لكن القوانين والمؤسّسات هي التي تفسدهم” في إشارة إلى طبيعة العقد الاجتماعي أو الدستور الذي يحكم الأفراد والجماعات، وبالأدق قدرة السلطة والقوانين على إيجاد آلية للالتزامات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، بوصفها علاقة جدلية تؤدّي، في نهاية المطاف، إلى تحقيق الإرادة العامة، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، فلا دولة بدون سيادة، ولا سيادة بدون إرادة عامة مشتركة، ولا إرادة عامة بدون عقد اجتماعي يعكس تطلعات الجميع.
أدّت التطورات التاريخية لفكرة الدولة بعد مؤتمر وستفاليا (1648) إلى إنهاء الحروب الدينية في أوروبا، وحل المشكلة الطائفية. كما أدّت التطورات التاريخية لمفهوم الديمقراطية والهزات التي عانتها أوروبا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الانتقال من فكرة الدولة القومية إلى دولة المواطنة حلّاً لإشكاليات الهويات الفرعية وصراعاتها، فأصبح الفرد وبغض النظر عن خصوصيته مواطناً له الحق في أن يكون له وطنٌ، لا يعيش فيه فحسب، وإنما يشارك في بنائه.
أسّست فكرة المواطنة لتدوين الحقوق الطبيعية، أو ما يسميها بالمفهوم الإيكولوجي عالم العقائد توماس بيري ( 1914- 2009) بـ “شريعة الأرض”، أي الحقوق التي تولد مع الإنسان وفي بيئته، ومنها الحقّ في الحياة والوجود، والحقّ في الحرية، والحق في التعبير، والحقّ في الكرامة، والحق في الملكية، بوصفها حقوقاً متأصلة في النفس البشرية وموجودة في مراحل ما قبل الدولة، ومن ثم، لا يحقّ لأية سلطة مصادرتها أو النيْل منها.
عرفت سورية أولى إرهاصات تشكيل الهوية الوطنية خلال فترة الحكم العثماني، عندما أسّس بطرس البستاني ( 1819- 1883) صحيفة “نفير سورية” أول صحيفة وطنية، كما أسّس “المدرسة الوطنية العليا” التي ضمّت طلاباً من جميع الطوائف.
منذ تأسيس الدولة 1920، لم تشهد سورية أي حراك جماهيري يعكس الممارسة الفعلية لديمقراطية قادرة على بلورة هوية سورية نابعة من فكرة سيادة الشعب. ولهذا، لم تعرف سورية حكومة وطنية بشرعية شعبية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فقد كانت غالبية الحكومات السورية نتاج تحالفات كولونيالية. على سبيل المثال، ضمّت الوزارة الأولى بعد إعلان الاستقلال في مارس/ آذار 1920 مجموعتين، هما مجموعتا رضا باشا الركابي الموالي للإنكليز وعلاء الدين الدروبي الموالي للفرنسيين، تزامن ذلك مع تشكيل برلمانات بديمقراطية هشّة، أوصلت المتنفذين، والباشوات، والإقطاعيين، والتجار، وشيوخ العشائر من جميع الطوائف والإثنيات.
طوال فترة الاحتلال الفرنسي، استمر استنساخ الأزمة البنيوية للهوية السورية نتاجاً كولونيالياً، فتشكّلت هوية سياسية نخبوية هي الأخرى من تجّار المدن، وكبار ضباط الجيش العثماني السابقين، والإقطاعيين، وشيوخ القبائل، والأشراف، ورجال الدين، والوجهاء، بصفتها تركيبة غير متجانسة هوياتياً بالمعنى الوطني، تجمعها، أفقياً، المصالح وتقاسم السلطة، بينما تغيب، عمودياً، الجماهير السورية؛ في دولةٍ صُممتْ بالأساس بطريقة استعمارية، بحيث يصعب على أية دولة خارجية الانتصار فيها وحدها، كما يصعب على أي طرف سوري الاستئثار بها داخلياً. وهو ما يفسّر بقاءها محكومة بثنائية الانقلابات والاستبداد، كما هشاشتها في مواجهة التحديات الخارجية، بسبب متواليات القضم الجغرافي من أجزائها منذ الاستقلال.
مع انقلاب 1970 الذي أسس للمرحلة الأسدية 1970- 2024 جرى من جديد، وبطريقة ما، استنساخ التحالف الكولونيالي ذاته للهوية السورية، بوصف ذلك تركيبة جاهزة للاستئثار بالسلطة، حيث عقدت السلطة في مرحلة الأسد الأب وابنه تحالفاتها مع كبار التجار في تزاوج خبيث بين المال والسلطة، كما أعادت صياغة المشيخة من داخلها على أسس ولائية، وأفرغت العقيدة العسكرية للجيش واستبدلتها بالأجهزة الأمنية؛ فتحوّلت سورية إلى دولة عسكرتارية شمولية، تئن فيها جميع الطوائف والإثنيات تحت وطأة الولاء للسلطة، الذي نقل الهوية السورية من مرحلة القلق إلى الإلغاء، فعاشت سورية حكماً بوليسياً يخفي تحت رماده، جمر الصراعات البينية سياسياً، وطبقياً، ومناطقياً، وطائفياً، وعشائرياً، وهي التصدّعات التي أسّست في مراحل لاحقة لانفجار مجتمعات المخاطر في مارس/ آذار 2011.
أدّى تحوّل الثورة السورية إلى صراع طائفي مخيف وبدفع خارجي إلى تصاعد الهويات الفرعية السورية، وبالأخص المذهبية منها، ما دفعها إلى الانكفاء على خصوصيتها حالة طبيعية في النفس البشرية خلال الأزمات. وتصاعدت المسألة الطائفية أكثر مع سقوط النظام، خصوصاً مع رفض آليات إدارة المرحلة الانتقالية، التي رأت فيها باقي الطوائف وبعض الكرد، وكثير من النخب السنية، استئثاراً لسلطة دينية سنّية بعينها، تجافي تطلعات السوريين في التشاركية والمواطنة. وهو الموقف الذي يأخذ بالتزايد بين السوريين يوماً بعد، خصوصاً بين قوى المعارضة من السياسيين والعسكريين والمدنيين المنشقين عن النظام، الذين بدؤوا يشعرون بأنهم فئة غير مرغوب فيها في عقلية الحكم الجديد، ما يضع سورية أمام حالة من اتساع دوائر الانقسام السوري طائفياً، وإثنياً، وسياسياً.
يقف السوريون اليوم أمام استحقاقٍ أخير مهم ومفصلي، متمثلاً في الهيئة التشريعية ولجنة صياغة الدستور في مرحلة قلقة وهشّة يقف فيها الجميع أمام خطر وجودي؛ ولحظة تاريخية يجدُر بهم اقتناصها لإعادة صياغة هويتهم السورية من خلال البحث عن مشتركاتهم التاريخية، بدءاً من الأخذ بنعمة التعدّدية في المجتمعات المتحضرة، والتوجه إلى ما هو جامع. فهم عرب من مسيحيين وعلويين ودروز وسنة، وهم مسلمون من كرد وعرب.
سورية اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى دستور عصري يؤطّر الهوية السورية، ويصوغ عقدها الاجتماعي في إطار دولة المواطنة، الكفيلة وحدها بإبعاد غول الطائفية الذي يطلّ برأسه على جميع السوريين، وفي أضعف حالاتهم من الجوع، والخوف، والدمار، والانقسام. وهي المهمّة التي تبدأ من ثورة ثقافية بخطاب سوري جامع، يطفئ نار النكايات الطائفية قبل أن يكتوي بها جميع السوريين.
العربي الجديد،
——————————
حرائق الطائفية في سوريا تشتعل من جديد وسط صمت العدالة/ دانيالا ويلسن
12.05.2025
القلق منتشر بشكل خاصّ بين الطلاب الدروز في دمشق، وفي حمص، وحتى في اللاذقية، بعد أن سُجّلت هتافات طائفية وتهديدات ضدّهم داخل الجامعات ومساكن الطلّاب، تقول الطبيبة الشابة:”شاركت في مظاهرة في ساحة الأمويين عندما سقط النظام، يبدو ذلك وكأنه زمن بعيد”.
في بلدة الصورة الكبيرة الدرزية الصغيرة الواقعة على مدخل محافظة السويداء من جهة دمشق، يلوح مقام الخضر الديني متفحّماً. الهواء مُشبع برائحة الحجارة المحترقة والقماش المشتعل. نجمة خماسية؛ رمز الديانة الدرزية، اقتُلعت من سقف المقام.
“دخلوا وهم يصرخون الله أكبر، ثم استخدموا شموع المقام ليُشعلوا فيه النار”، يقول ليث؛ عامل بلدية محلّي يرتدي الآن ملابس قتالية: “ثم أهانونا بهتافات طائفية”، يرفض ليث قول المزيد خجلاً.
يقول رجل يقف بجانب ليث: “أنتم خنازير، خونة، أخواتكم عاهرات. هذا ما كانوا يصرخون به”.
بدأ الهجوم عند الفجر في 30 نيسان/ أبريل، وأمطرت قذائف الهاون على القرية لساعات. قرابة الساعة 6:30 صباحاً، وبعد توقّف وجيز سُمح للعائلات بالفرار، دخل مسلحون القرية، نهبوا البيوت، وأحرقوا المحالّ التجارية، وعبثوا بالمقام. لم ينجُ محلّ واحد، بحسب السكّان.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، بل كانت جزءاً من موجة أوسع من العنف الطائفي، الذي استهدف المجتمعات الدرزية في سوريا، اشتعلت بعد تداول مقطع صوتي منسوب إلى شيخ درزي يُقال إنه أساء للنبي محمد.
سارع زعماء في الطائفة إلى نفي الاتّهام، كما أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً يوم الثلاثاء في 29 نيسان/ أبريل، أعلنت فيه فتح تحقيق، لكنّ الضرر كان قد وقع.
بعد واحدة من أشد أحداث العنف الطائفي في تاريخ سوريا الحديث، وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قُتل ما لا يقل عن 134شخصاً بعد أسبوع من الاشتباكات في المناطق ذات الأكثرية الدرزية “السويداء، جرمانا، صحنايا، أشرفية صحنايا”.
شمل القتلى 88مقاتلاً درزياً، 14 مدنياً، 32 جندياً من وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية، وقوات عسكرية تابعة لهم.
شهود عيان يقولون إن عناصر من إدارة الأمن العامّ، أي شرطة الدولة الداخلية، كانوا حاضرين ومتواطئين، وتؤكّد بعض اللقطات التي انتشرت عبر الأنترنت وجودهم، لكنّ دورهم الكامل لا يزال غير واضح.
في الصورة الكبيرة، قُتل مدنيان، أحدهما كان عمّ ليث الذي: “كان جالساً فقط، أعزل. أطلقوا النار عليه، لم نتمكّن من سحب جثّته حتى اليوم التالي”، رصاصات فارغة على الأرض، وعلى جدار قريب، لطخات الدماء وثقوب أحدثها الرصاص تشهد على ما حدث.
يقول ليث بصوت متهدج: “اقتحموا أيضاً منزل والدي وعمره 82 سنة وضربوه، مزّقوا صورة عمّتي، رفعوها من على الحائط وداسوها، وهي كانت توفّيت قبل شهر”.
امتدّ العنف أيضاً إلى ضواحي العاصمة. في 29 نيسان/ أبريل، اندلعت اشتباكات في جرمانا، المدينة ذات الغالبية الدرزية جنوب دمشق. بعد أسبوع، امتلأت محطّة الحافلات في المدينة بمئات العائلات التي تحاول المغادرة، الطريق إلى السويداء مغلق، ولم يتبقَّ سوى بضع حافلات لنقل الناس.
ساندرا، طبيبة تبلغ من العمر 29 عاماً، تحاول الحصول على مقعد في إحدى الحافلات حيث الجو خانق، والركّاب يحشرون أنفسهم ثلاثة أشخاص في مقاعد مخصّصة لشخصين تقول: “كلّ الدروز يريدون العودة إلى السويداء. من بقي، بقي فقط بسبب عمله”.
العنف، الذي وثّقته مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار قلقاً وجودياً في أوساط الطائفة، التي تخشى أن تلقى المصير نفسه الذي لاقاه علويون في مجازر الساحل، التي وقعت قبل أسابيع.
كلّ شخص من الذين التقيناهم يعرف أحداً مات، أو جُرح، أو فُقد، أو شارك في القتال.
القلق منتشر بشكل خاصّ بين الطلاب الدروز في دمشق، وفي حمص، وحتى في اللاذقية، بعد أن سُجّلت هتافات طائفية وتهديدات ضدّهم داخل الجامعات ومساكن الطلّاب، تقول الطبيبة الشابة:”شاركت في مظاهرة في ساحة الأمويين عندما سقط النظام، يبدو ذلك وكأنه زمن بعيد”.
تعمل ساندرا في مستشفى “المجتهد” في دمشق، ولا تعرف إن كانت ستحظى في السويداء بأمان أكثر من دمشق، لكنّها تبرر سفرها”على الأقلّ سأكون مع عائلتي”. “رأيت ذلك بعيني قبل أربعة أيّام”، تواصل بصوت منخفض: “وصل تسعة جرحى من صحنايا إلى قسم الطوارئ، حاولت إحضار طعام لهم، أوقفني الأمن العامّ، وسألوني عن اسمي، قال لي صديق إنهم سخروا من الرجال لأنهم دروز، كما طُلب من الأطباء عدم إجراء تدليك قلبي لرجل مصاب، وتوفّي لاحقاً”.
عند أحد الحواجز تتوقّف الحافلة، تنظر ساندرا بقلق إلى رجال الأمن العامّ الواقفين في الخارج: “لا أثق بهم. لكن ليسوا جميعاً متشابهين، بعضهم طلب من الآخرين أن يتراجعوا عندما سألوا عن اسمي. وليس كلّ السنة متشدّدين، بل العكس، لدي أصدقاء منهم ساعدوني على الحصول على إجازة من المستشفى”.
امرأة أخرى، تقف قريبة تستمع: “أنتِ تعملين في مستشفى المجتهد؟ جدّي أُصيب في صحنايا الخميس الماضي، سمعنا أنه نُقل إلى هناك، لكن عندما جئنا لرؤيته، طردنا الأمن العامّ، ثم قيل لنا إنه نُقل إلى داريا للاستجواب. لا أخبار عنه منذ ذلك الحين، مرّ أربعة أيّام، عمره 75 سنة”.
هذه الموجة من العنف الطائفي ليست مجرّد ردّة فعل، إنها تعكس أحقاداً قديمة، نزاعات على الأراضي، ودوائر انتقام، وتفتّت عميق في سوريا ما بعد الحرب.
سامي وردة، ناشط يبلغ من العمر 27 عاماً من جرمانا، يحاول توثيق العنف مع مجموعة من أصدقائه: “خلال الحرب الأهلية، انضمّ 300 رجل من بلدتنا إلى ميليشيات الشبّيحة، قاتلوا في المليحة في عام 2014″، المهاجمون مؤخّراً جاءوا من هناك: “بعض مقاتلي حزب الله كانوا متمركزين أيضاً في جرمانا، وشاركوا في تلك المجازر آنذاك”.
بعض التحالفات التي تشكّلت خلال الحرب الأهلية والنزاعات المحلّية تشكّل فوضى اليوم.
رعب صامت في الساحل
في حمص وعلى طول المحافظات الساحلية، موطن الأقلّية العلوية في سوريا، الإحساس بالتهديد واضح، وإن كان أقلّ ظهوراً حالياً. في 6 آذار/ مارس، هاجم موالون سابقون للنظام القوّات الحكومية، مما أشعل مجازر أسفرت عن مقتل 1,334 شخصاً، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، منذ ذلك الحين، استمرّ العنف في الظلّ، أحد الاتّجاهات المقلقة: خطف نساء علويات
سجّلت “مجموعة السلم الأهلي “، وهي منظّمة غير حكومية تأسّست بعد سقوط الأسد، 72 حالة خطف نساء، منذ كانون الثاني/ يناير في شرق سوريا وحده.
علي حسن لم يسمع عن شقيقته منذ 13 نيسان/ أبريل شيئاً: “كانت بتول في حافلة متّجهة إلى صافيتا، كانت تراسل زوجها لتطمئن على ابنهما، ثم ساد صمت بعد الساعة الرابعة عصراً”.
آخر صورة لها تُظهرها مبتسمة، بالكحل حول عينيها، مصيرها مجهول يضيف حسن: “ذهبنا إلى الشرطة، واتّصلنا بمعارفنا في الأمن العامّ لا شيء”.
لا يتّهم حسن السلطات بشكل مباشر، لكنّ تقاعسهم يقول الكثير، يقول : “ليسوا مسيطرين، لا يملكون العدد أو القدرة، لو طُبّقت العدالة منذ البداية، لما حدث هذا كلّه”.
تعلو الأصوات المطالبة بتحقيق عدالة انتقالية. ضحايا، ونشطاء، وشخصيّات من المجتمع المدني يقولون إنها السبيل الوحيد لكسر دوائر الانتقام في سوريا، لكنّ السلطات تلتزم الصمت.
بعد مجازر آذار/ مارس، وعدوا بلجنة تحقيق، كان من المُفترض إصدار تقرير خلال شهر، تأخّر بالفعل لشهرين. هذا يغذّي شعوراً بالظلم، في الوقت الذي تخرج فيه سوريا من 14 عاماً من الحرب الأهلية، مُثخنة ولكنّ من دون دم.
درج
————————————–
=========================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 13 أيار 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
—————————–
«العمال الكردستاني» يتجه لحل نفسه بعد دعوة أوجلان التاريخية.. ما الخطوات المرتقبة التي ستنهي صراعاً دام 47 عاماً مع الدولة التركية؟
عربي بوست
تم النشر: 2025/05/10
بعد شهرين من توجيه زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان “دعوتَه التاريخية”، عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره الخاص معلناً أنه اتخذ “قرارات تاريخية” في إطار حل نفسه ونزع سلاحه، في خطوةٍ تنهي 47 عاماً من الصراع مع تركيا.
وذكرت وكالة فرات للأنباء المرتبطة بحزب العمال الكردستاني أن المنظمة الكردية عقدت مؤتمراً ما بين 5 و7 مايو/أيار 2025، واتخذت “قرارات تاريخية” تصب في منحى حل نفسها.
وأشارت إلى أنه “سيتم مشاركة المعلومات المفصلة بشأن القرارات المتخذة إلى الرأي العام في أقرب وقت ممكن”.
وتأخر الإعلان عن نتائج المؤتمر بسبب وفاة النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سري سُريا أوندر (62 عاماً)، السبت الماضي، وهو أحد مهندسي الحوار بين أنقرة والحزب.
توقعات بالإعلان قريباً
وقالت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية الكردي “DEM” عائشة غول دوغان إن “حزب العمال الكردستاني قد يعلن عن نتائج مؤتمره في أي لحظة، نحن ننتظر أيضاً هذه الخطوة التاريخية”.
وأضافت دوغان: “نأمل أن تتحول هذه الفرصة إلى سلام دائم من خلال الحوار، مع وضع أسس سياسية وقانونية متبادلة”.
وخلال اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزراء ونواب حزبه في مقر حزب العدالة والتنمية في 8 مايو/أيار، قال أردوغان: “لقد تغلبنا على كافة العقبات، وسيلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه اليوم أو غداً، وسيتم حل المنظمة، وبعد ذلك سيبدأ عصر جديد لنا جميعاً”.
فيما يتوقع مسؤولو حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أن يعلن حزب العمال الكردستاني، بداية الأسبوع المقبل، بحسب شبكة “بي بي سي” بالنسخة التركية، فيما ذكرت مصادر لصحيفة “حرييت” أنه من المتوقع أن يصدر الإعلان اليوم.
وكان أوجلان قد وجّه في 28 فبراير/شباط 2025 “دعوة تاريخية” إلى منظمته التي تتهمها تركيا بـ”الإرهاب”، بالاستسلام وإلقاء السلاح، وحملت رسالته عنوان “دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي”.
أوجلان في رسالته مخاطباً العمال الكردستاني: “اعقدوا مؤتمركم واتخذوا القرارات اللازمة للاندماج مع الدولة والمجتمع؛ يجب على جميع المجموعات إلقاء سلاحها، ويجب على التنظيم حل نفسه”.
وفي خطوة غير متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فاجأ زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الجميع بمصافحته نواب حزب المساواة والديمقراطية الكردي “DEM”، موجهاً دعوة إلى أوجلان بالحضور إلى البرلمان، وداعياً منظمة العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح، مقابل الاستفادة من “حق الأمل” أي العفو عنه.
وفي الوقت الذي سقطت هذه الدعوة مثل “القنبلة” على الأجندة السياسية التركية، لاسيما من زعيم تركي عارض دائماً وبشدة التفاوض مع المنظمة الكردية، بدأت المفاوضات مع حزب “DEM” بدعم من أردوغان، الذي علّق قائلاً: “لا مكان للإرهاب وجانبه المظلم في مستقبل تركيا، نريد أن نبني تركيا خالية من الإرهاب والعنف معاً، ولا ينبغي التضحية بنافذة الفرصة التاريخية من أجل بعض الحسابات”.
كيف استقبلت الحكومة التركية خطوة حزب العمال الكردستاني؟
وفي تعليقه على عقد المؤتمر، قال كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون الخارجية والأمن عاكف شغتاي كيليش إنهم يراقبون العملية الجارية، وقبل كل شيء يجب التخلي عن الأسلحة بكافة أشكالها.
وأضاف لشبكة “سي أن أن” التركية أنه يجب السير في الطريق الذي أعلنه الرئيس أردوغان بـ”تركيا خالية من الإرهاب”، وستكون هناك فترات صعبة في بعض الأحيان، ولكن ما يتوقعه الجميع هو ألا يبقى أي تهديد إرهابي في البلاد.
ولا يرى قادة حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” أن إعلان قرار الحل كافٍ، والاتجاه السائد هو مراقبة موقف المنظمة الكردية بعد الحل من أجل اتخاذ خطوات التحول الديمقراطي الشامل.
وفي تصريحات لقناة 24 التركية، علّق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره قائلاً: “يبدو أننا سنظل في حالة ترقّب لبعض الوقت، في انتظار أن نسمع ردّ التنظيم على هذه الدعوة التاريخية”.
وشدّد فيدان على أن الجميع يرغب في التحلي بالتفاؤل بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الأرضية التي كان يستند إليها الإرهاب في تركيا قد زالت منذ وقت طويل، غير أن التنظيم لا يزال يجد لنفسه موطئ قدم في الدول المجاورة التي تعاني من استمرار حالة عدم الاستقرار.
وحول سيناريوهات إلقاء “بي كي كي” السلاح، قال فيدان: “على الجميع أن يعمل من أجل بناء أرضية لا وجود فيها للسلاح، تنتهي فيها حالة اللاشرعية، ويتمكن الناس من ممارسة عملهم السياسي بطرق حضارية وضمن الأطر القانونية”.
وأكد على ضرورة تفكيك التنظيمات غير القانونية والبنى الاستخباراتية غير الشرعية، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيا متأهبة للاحتمالات الأخرى في حال لم يُلقِ التنظيم الكردي سلاحه.
وأوضح أنه في حال تم تفكيك منظمة العمال الكردستاني وألقت السلاح “لن تُسفك المزيد من الدماء، ولن تبقى الوحدة المجتمعية مهددة باستمرار، بل سيتم التمهيد لنظام إقليمي أكثر تقدماً”.
ورداً على سؤال حول وجود “بي كي كي” في سوريا والمسار الذي قد يتخذه تنظيم “واي بي جي” في هذه المرحلة، قال فيدان إنه في حال قرر “بي كي كي” حلّ نفسه والتخلي عن السلاح “فسنرى جميعاً بمرور الوقت كيف سينعكس هذا القرار على أذرعه في سوريا والعراق”.
ما هي الخطوة التي ستتبع إعلان حزب العمال الكردستاني حلَّ نفسه؟
وفي بيان أصدره بعد انتهاء مؤتمر حزب العمال الكردستاني، أشار حزب المساواة والديمقراطية إلى الترتيبات التي سيتم اتخاذها في البرلمان التركي.
وأكدت القيادية بالحزب بيرفين بولدان أن “الجزء الأصعب قد انتهى” مع عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره، وقالت: “الآن، بالطبع، حان الوقت لاتخاذ خطوات نحو الديمقراطية، نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن السلام سيحل في تركيا”.
وخلال اجتماعه مع وزير العدل يلماز تونج، في 24 أبريل/نيسان 2025، نقل حزب المساواة والديمقراطية وجهات نظره بشأن الخطوات التي ينبغي للسلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذها من أجل التقدم السليم للعملية وتحقيق الديمقراطية.
كما أنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لحزب المساواة والديمقراطية، الإثنين 12 مايو/أيار 2025، لمناقشة وإعلان توصياته بشأن الخطوات التي يجب أن تتخذها السلطات التركية، بالإضافة إلى خارطة الطريق لهذه العملية.
وتتضمن مقترحات حزب المساواة والديمقراطية:
تحسين ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان، وتوسيع مجالات تواصله، والسماح بلقائه الصحفيين والأكاديميين وممثلي الأحزاب السياسية، ومنحه الحق في استخدام الهاتف.
اتخاذ خطوات لتوفير الضمانة التركية للعملية القانونية التي تصفها الحكومة بـ”تركيا بلا إرهاب”.
وضع الترتيبات القانونية لتسهيل إطلاق سراح المعتقلين المرضى.
تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية بشأن “السجناء السياسيين”، وخاصة صلاح الدين دميرتاش.
ووفقاً لصحيفة “حرييت” التركية وشبكة “بي بي سي” النسخة التركية، فإنه بعد إعلان قرار الحل:
يدخل “بروتوكول تسليم الأسلحة”، و”وضع أعضاء المنظمة الذين ألقوا أسلحتهم” قيد التنفيذ.
تقول مصادر في حزب العدالة والتنمية إن دراسات “فنية” تجري حالياً من الوحدات المختصة بالدولة بشأن قضية نزع سلاح المنظمة.
من المتوقع أن يُطرح تشريع جديد في البرلمان التركي من أجل العفو عن أعضاء المنظمة غير المتورطين في الجرائم.
من المتوقع أن يتم نقل قادة حزب العمال الكردستاني إلى دولة ثالثة، وعدم عودتهم إلى تركيا.
يطالب حزب المساواة والديمقراطية الكردي بتغيير ظروف اعتقال أوجلان في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، وإطلاق سراحه بموجب قانون “الحق في الأمل”.
ومن المتوقع أن تُدرج على جدول الأعمال في البرلمان التركي القواعد المتعلقة بتطبيق معدلات “الإعدام المتساوي” على جميع أنواع الجرائم، وذلك اعتماداً على المناخ الذي سينشأ بعد قرار حل المنظمة.
ولا يفكر حزب العدالة والتنمية في اتخاذ أي خطوات بشأن قانون تعيين أمناء البلديات في الوقت الراهن، ولكن في أعقاب قرار حل حزب العمال الكردستاني، سيتم إيقاف تعيين الأوصياء، مع إمكانية إعادة تعيين بعض رؤساء البلديات إذا لم تكن لديهم أي جرائم أخرى.
أبرز محطات الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني خلال 47 عاماً
تأسس حزب العمال الكردستاني بقيادة عبد الله أوجلان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978، في قرية “فيس” بمنطقة ديار بكر جنوب تركيا.
بدأ الحزب العمل المسلح في 15 أغسطس/آب 1984، فيما سُمِّي بـ”قفزة آب 1984″، عندما شن هجمات على مراكز الدرك في إروه بولاية سيرت، وشمدينلي بولاية هكاري، وشكّلت منعطفاً في مسار الصراع.
استخدم حزب العمال الكردستاني سوريا ملاذاً آمناً له حتى عام 1988، وعاش في مخيمات في سهل البقاع اللبناني لسنوات، وتلقى تدريبه على الأسلحة هناك.
نفذ حزب العمال الكردستاني أعنف هجماته في تسعينيات القرن الماضي، وشن هجمات طالت المدنيين والشرطة والجيش التركي.
تلقى الحزب ضربة موجعة بعد أن اعتقلت المخابرات التركية أوجلان في 15 فبراير/شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بعد مغادرته سوريا تنفيذاً لالتزامات اتفاقية أضنة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1998، وتنقل بين دول مثل اليونان وروسيا وإيطاليا وطاجيكستان، وكانت جهود اللجوء في بلدان مختلفة غير ناجحة.
حُكم على أوجلان بالسجن مدى الحياة في عام 2002، بسبب إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا في إطار قوانين المواءمة في الاتحاد الأوروبي.
استغل حزب العمال الكردستاني الفراغ في السلطة في شمال العراق بعد حرب الخليج عام 2003، فقام بتدريب مقاتليه حول جبل قنديل، وأنشأ معسكرات مختلفة.
تبنى حزب العمال الكردستاني فكرة العمل ضمن حدود الدول القومية في الشرق الأوسط، وفي المؤتمر الذي عُقد في يناير/كانون الثاني 2000، تبنى البرنامج الجديد مقولة مفادها: “إقامة دولة منفصلة ليس ضرورياً ولا واقعياً في عالم القرن الحادي والعشرين”، وتسبب ذلك بانشقاقات داخلية نجم عنها مغادرة المئات من صفوفه.
وفي أبريل/نيسان 2004، قرر الاتحاد الأوروبي إدراج حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وتلا ذلك قرار مماثل من الولايات المتحدة، ليُعلن الحزب في يونيو/حزيران من العام ذاته إنهاء وقف إطلاق النار الذي التزم به منذ عام 1999، حيث توغلت أعداد كبيرة من المقاتلين عبر الحدود إلى الداخل التركي، ما دفع أنقرة لتكثيف عملياتها لملاحقة المسلحين على الحدود.
وفي عام 2005، تم التأكيد على أن حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى إعادة هيكلته وتأسيسه في إطار حل المشاكل في الشرق الأوسط، وتبنى أوجلان من سجنه فكرة “الكونفدرالية الديمقراطية”.
بعد أربع سنوات من ذلك، أطلقت الحكومة التركية “عملية الانفتاح الديمقراطي” لتعزيز حقوق الأكراد وفتح قنوات الحوار، وتعززت تلك الجهود بإطلاق “حزمة حقوق الإنسان” في عام 2010، مما سمح ببث برامج بالكردية وتخفيف نقاط التفتيش الأمنية في المناطق الكردية جنوب البلاد.
في عام 2012، بدأت الاستخبارات التركية محادثات مباشرة مع عبد الله أوجلان في سجنه للتفاوض حول وقف إطلاق النار وحل النزاع سياسياً.
في عيد النوروز عام 2013، دعا أوجلان المنظمة إلى وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح.
ولكن الأزمة السورية تسببت في تصاعد التوترات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، حيث استولت “قسد” على مناطق واسعة قرب الحدود التركية، ما أثار قلق أنقرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، تسببت احتجاجات كوباني في اندلاع أعمال عنف واسعة بين أنصار حزب “هدى بار” وحركة الشباب الثوري الوطني التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبعد محادثات مع أوجلان والجناح الكردي، انخفضت التوترات.
وانهار وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ عام 2013، في 22 يوليو/تموز 2015، بعد أن قتل حزب العمال الكردستاني اثنين من ضباط الشرطة في منزليهما، في أعقاب تفجير مدينة سروج الذي نُسب إلى “تنظيم الدولة”.
وفي 25 يوليو/تموز 2015، هاجم مقاتلو الحزب قافلة عسكرية في ديار بكر وقتلوا جنديين اثنين.
وتوالت بعد ذلك المواجهات المسلحة بين الطرفين، فقامت تركيا بقصف أهداف تابعة للحزب في العراق، وقادت هجوماً عسكرياً واسع النطاق على بعض البلدات التي تُعتبر معقلاً له في جنوب تركيا وشمال سوريا.
ومنذ أغسطس/آب 2015، وقعت العديد من الاشتباكات في مناطق محافظة شرناق في تركيا، وتم حفر الخنادق من قِبل أعضاء الحزب، حيث فرضت الحكومة التركية حظر التجول في عدة أحياء.
وأطلقت تركيا في عام 2018 عملية “غصن الزيتون” ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نفذت عملية “نبع السلام” في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى تغيير موازين القوى في المنطقة.
ومنذ ذلك الوقت، هددت تركيا بشن عمليات جديدة ضد الوحدات الكردية المسلحة في شمال شرق سوريا، وشنت هجمات ضد معاقل منظمة العمال الكردستاني في شمال العراق.
عربي بوست
———————————
حلّ «العمال الكردستاني»: ميزان الآمال والمخاوف
رأي القدس
إذا صحّت تقارير وكالة فرات للأنباء، المقربة من «حزب العمال الكردستاني»، فإن الحزب قرر بالفعل حلّ نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء تمرد عسكري دام أكثر من أربعة عقود، وأودى بحياة أكثر من 40 ألف ضحية في مناطق مختلفة من تركيا وجبال قنديل شمال العراق.
والبيان الختامي، الذي صدر عن مؤتمر للحزب عُقد الأسبوع الماضي في شمال العراق أيضاً، نصّ على الاستجابة لدعوة وجهها قائد الحزب التاريخي عبد الله أوجلان أواخر شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إمرلي، دعا فيها إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للحزب وإنهاء أنشطته. وقال البيان إن المؤتمر الثاني عشر قرر «حلّ الهيكل التنظيمي» و«إنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تجري باسم الحزب».
وهذه خطوة جديرة بالترحيب، والأمل في أن تتجسد كعتبة أولى على طريق المصالحة الوطنية بين الأكراد وسائر المكونات في تركيا، فلا تحقن الدماء البريئة التي أريقت خلال مواجهات عسكرية وعمليات إرهابية فحسب، بل تنقل إلى مراحل متقدمة جولات التفاوض المستمرة مع السلطات المركزية التركية حول حقوق الأكراد الثقافية والسياسية.
وهي أيضاً كفيلة بإنهاء عقود من تحالفات الحزب المتشابكة، التي لم تكن صائبة دائماً أو تخدم مصالح الشعوب الكردية، على غرار التحالف مع نظام حافظ الأسد وما انتهى إليه من صفقات عسكرية وأمنية مع أنقرة وعلى نقيض مصالح الحزب وجماهيره، فضلاً عن طرد أوجلان نفسه والتسبب في تسهيل اعتقاله سنة 1999. وليس من المستبعد بالتالي أن يسفر حلّ الحزب عن صياغات جديدة للعمل السياسي الشرعي لأكراد تركيا، ومتابعة المهام التي يقوم بها حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» الكردي، الذي تولى التفاوض مع أوجلان لإطلاق مبادرة حلّ «العمال الكردستاني».
لكن ميزان الآمال ينطوي أيضاً على مخاطر غير قليلة قد تؤدي إلى فشل هذه المبادرة التاريخية، بالنظر إلى امتداد الحزب خارج الأراضي التركية في العراق وسوريا وإيران، حيث تتضارب المصالح وتختلط الأوراق وتتناقض الأجنحة، سواء عند الأحزاب والقوى الكردية في البلدان الأربعة، أو داخل «العمال الكردستاني» ذاته.
فليس خافياً أن إيران تتمتع بنفوذ غير ضئيل لدى بعض قيادات الحزب المتحصنة في جبال قنديل خصوصاً، أمثال جميل بايك الذي يقود جناحاً يرفض إلقاء السلاح، وهو مقرب من الحرس الثوري الإيراني وسبق له أن تعاون مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق، كما تلقى هذا الجناح أسلحة مختلفة من إيران ضمت طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية مضادة للمسيرات التركية. وأنشطة هذا الجناح تتجاوز جبال قنديل إلى أرياف دهوك وسنجار ومناطق أخرى في شمال العراق وتركيا وسوريا، فضلاً عن تواجد نشط سياسي واستثماري وإعلامي في بلدان أوروبية عديدة.
والأمل منعقد على مصير إيجابي ينتهي إليه قرار «العمال الكردستاني» التاريخي، يختلف عن مصائر مبادرات سابقة في سنوات 1993 و1999 و2012 شهدت محاولات مماثلة لوقف إطلاق النار، وتمّ إجهاضها من هذا الطرف أو ذاك.
————————–
حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه: انعكاسات مباشرة على سورية/ محمد أمين و سلام حسن
13 مايو 2025
أعلن حزب العمال الكردستاني أمس الاثنين، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلّح مع تركيا، في خطوة ستكون لها تداعيات على الساحة السورية، حيث تسيطر تشكيلات مرتبطة أو تابعة لهذا الحزب عسكرياً وعقائدياً، على مساحة كبيرة من شمال شرقي البلاد. وقالت وكالة فرات للأنباء، المقرّبة من حزب العمال الكردستاني، أمس الاثنين، إن الجماعة التي تخوض صراعاً مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاماً، قررت حلّ نفسها وإنهاء التمرّد المسلّح. وقال حزب العمال الكردستاني في بيان نشرته الوكالة، إن المؤتمر الذي عقده قبل أيام، أكد أن نضال “العمال الكردستاني” أكمل مهمته التاريخية، وعلى هذا الأساس قرر حلّ البنية التنظيمية للحزب، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلّح، على أن يتولى زعيمه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إدارة العملية الحالية وتنفيذها، وبالتالي إنهاء العمل الذي كان يجري تحت اسم الحزب.
تداعيات حلّ حزب العمال الكردستاني على سورية
من المؤكد أن حلّ حزب العمال الكردستاني المصنّف في خانة التنظيمات الإرهابية لدى عدد من الدول، ستكون له تداعيات كبيرة على الساحة السورية، فالتشكيلات العسكرية التي تسيطر على شمال شرقي البلاد منذ عدّة سنوات، تابعة لذاك الحزب أو مرتبطة به على المستويات كافة، وخاصة الفكرية والعقائدية. ويُنظر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تأسّس في العام 2003، على أنه نسخة سورية من حزب العمال. ويُسيطر “الاتحاد” عملياً على شمال شرقي سورية من خلال وحدات “حماية الشعب” الكردية، وهي تشكيل عسكري يشكّل الذراع العسكرية لهذا الحزب، فضلاً عن كونه الثقل الرئيس في قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وبحسب مصادر مقرّبة من هذه القوات فإنه “سيتم التخطيط لهيكلية وحدات حماية الشعب في سورية بالتعاون مع الحكومة السورية”، مؤكدة، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هذه الهيكلية “تتضمّن إبعاد الأعضاء غير السوريين في المنظمة ودفعهم خارج البلاد، وسينضمّ الباقون إلى الجيش السوري”. وتضمّ وحدات “حماية الشعب” مقاتلين أجانب ينحدرون من العراق وتركيا وإيران، بعضهم يتولّى مفاصل القرار في “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سورية.
اتفاق بين الشرع وعبدي لإدماج “قسد” في الدولة السورية | نص الاتفاق
وقال قائد “قسد” مظلوم عبدي، في بيان أمس الاثنين، إن قرار حل حزب العمال الكردستاني “جدير بالاحترام”. وكان قال بعد أيام من إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن المقاتلين الذين قدموا إلى سورية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم قواته، سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سورية. ومن المتوقع أن يسرّع حلّ حزب العمال الكردستاني في طيّ ملف المقاتلين الوافدين من وراء الحدود. ومن التشكيلات العسكرية المرتبطة بشكل مباشر مع حزب العمال الكردستاني ما يُعرف بـ”الشبيبة الثورية”، والمتهمة من قبل منظمات حقوقية بخطف أطفال وقُصّر لتجنيدهم في صفوف حزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به. وإلى جانب هذه المنظمة، هناك مليشيا معروفة باسم “وحدات حماية المرأة”، تأسّست في العام 2013، وتضمّ اليوم آلاف النساء المتطوّعات في صفوفها.
ورأى شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي في سورية (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سورية)، في حديث مع “العربي الجديد”، أن تأثير حل الحزب الكردستاني نفسه “كبير على الملف السوري، ولا سيما من ناحية التعاطي التركي مع هذا الملف المتشابك”. واعتبر أنّ من شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً على التعاطي التركي مع الملف الكردي بشكل خاص، والملف السوري بشكل عام. وتابع: هذا إقرار كفيل بسحب الحجج والذرائع من يد الجميع الذين كانوا يحاربون الأكراد، أو يحاربون القضية الكردية ربما بحجّة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وأذرعه في المنطقة.
وأعرب عن اعتقاده أن قرار حلّ “العمال” في تركيا “سيؤدّي إلى حلّ أذرعه في سورية، وعلى رأسها منظمة الشبيبة الثورية المتطرّفة التي كانت تعبث بأحزاب المجلس الوطني الكردي، وكذلك بالناس في معظم المدن والقرى الكردية طيلة السنوات المنصرمة”. وبرأيه، فإن “من شأن هذا القرار حلّ عقدة المقاتلين الأجانب في صفوف قسد، والتي تُعدّ خلافية بين الحكومة السورية وبين قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم سيُعبّد الطريق لتطبيق الاتفاق الذي وقّعه مظلوم عبدي مع رئيس الجمهورية (أحمد الشرع)”.
حل “الكردستاني” سيخلق مناخات إيجابية
وأعرب كدو عن اعتقاده أن حلّ حزب العمال الكردستاني “سوف يخلق مناخات إيجابية، ليس في سورية وحدها، وإنما في المنطقة برمّتها، سواء كان في تركيا أو في العراق أو في شمال شرق سورية”، مضيفاً: هذا القرار جاء في مرحلة مفصلية وجدّاً مهمة، ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً على مجمل الأمور في سورية، وليس على الملف الكردي لوحده. غياب حزب العمال الكردستاني ومسلحيه من سورية من شأنه أن يُرسّخ الثقة بين الأطراف الكردية، من جهة، وبين هذه الأطراف الكردية مجتمعة وبين السلطات السورية من جهة أخرى.
وكان الشرع قد وقّع مع عبدي اتفاقاً في مارس/آذار الماضي لدمج “قسد” في المنظومة العسكرية السورية، وحلّ ملف الشمال الشرقي من سورية. إلا أن تطبيق الاتفاق واجه صعوبات في ظلّ سقوف تفاوضية عالية من قبل الجانب الكردي، ومطالب ترى دمشق أنها “غير واقعية”، وبعضها غير قابل للتطبيق، من قبيل مبدأ اللامركزية في البلاد. ومن المرجّح أن يدفع قرار حلّ حزب “العمال” قوات سوريا الديمقراطية والقوى الكردية إلى تخفيض سقف مطالبها، ما يُسهّل ربما من حسم القضايا العالقة من دون الاضطرار إلى صدام عسكري.
ورأى الباحث السياسي بسام سليمان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الأكراد السوريين “يرغبون في التوصل لحلّ سياسي لقضيتهم، وخاصة أن هناك بوادر انسحابات أميركية من مناطق كثيرة في شمال شرقي سورية”.
وتابع: يدرك الأكراد أن وجود الولايات المتحدة العسكري ليس دائماً، فضلاً عن أن العرب في شمال شرقي سورية لن يصبروا طويلاً على هذا الحكم (سلطة قسد)، خصوصاً أنه لم يُحقّق إنجازات إدارية حقيقية رغم وجود الموارد. وبرأيه، فإن من شأن حلّ حزب العمال الكردستاني “تعزيز الصراع أو الصدام بين الجناح السوري داخل قسد، وأقصد هنا الجناح الكردي السوري بقيادة مظلوم عبدي، والجناح غير السوري”.
من جانبه، أعرب المحلل السياسي الكردي فريد سعدون، في حديث مع “العربي الجديد”، عن اعتقاده أن تركيا “سوف تقبل بوجود الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية، مقابل حلّ حزب العمال وإلقاء السلاح”. وتوقع سعدون توجّه آلاف المقاتلين الموجودين في جبال قنديل إلى كردستان العراق، وإلى شمال شرق سورية، وخاصة الذين يحملون الجنسية التركية، مضيفاً: سوف نشهد قفزة كبيرة في عدد المقاتلين والسلاح والأموال. وبيّن أن عدد المقاتلين السوريين في حزب العمال المنحلّ “كبير”، مضيفاً: الحزب قائم على أكتاف السوريين، بالتالي سيعودون، مثلما عاد مظلوم عبدي وغيره إلى شمال شرق سورية.
—————————-
حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه: سيناريوهات متوقعة على الجغرافية العراقية/ عثمان المختار
13 مايو 2025
جاء إعلان حزب العمال الكردستاني التركي، أمس الاثنين، حلّ نفسه، بمثابة الحدث العراقي الرئيسي، نظراً للوجود الواسع لمقاتلي الحزب داخل العراق، وسيطرتهم على مناطق جغرافية كبيرة في الشمال العراقي، تتعدى إقليم كردستان، لتصل إلى نينوى وأطراف كركوك بمساحة تتجاوز أربعة آلاف كيلومتر مربع. مع العلم أن تقديرات عراقية تشير إلى وجود 20 منطقة عراقية رئيسية خاضعة لسيطرة “الكردستاني” إلى جانب نحو 380 قرية.
الإعلان عن حلّ الحزب نفسه تلقفته بغداد، والتي أدرجت الحزب “منظمةً محظورة” العام الماضي، بترحيب كبير، حيث ستترتب عليه حزمة كبيرة من التغييرات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، في حال تمّ تنفيذه، لا سيما أن تداعياته أيضاً ستطاول العلاقة مع تركيا، خصوصاً لناحية الوجود التركي العسكري داخل العراق.
تنفيذ الإعلان التاريخي بحلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإنهاء العمل المسلح، لا يُتوقع أن يكون سريعاً، وفقاً لمسؤولين وباحثين مختصين، نظراً لضخامة البنى التحتية العسكرية للحزب وخريطة انتشار عناصره، والعدد الكبير من الملاحقين قضائياً داخله من الدولة التركية، وكذلك الحاجة إلى فهم الخطوة التركية المقبلة، والتي يقول مراقبون وسياسيون مطلعون على أوضاع الحزب لـ”العربي الجديد”، إنها “يجب أن تشمل عفواً عاماً عن الذين لا يملكون أي قيد جنائي”، في إشارة إلى المنخرطين في “الكردستاني” والذين لم يتورطوا بمهاجمة القوات التركية أو تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي التركية.
حزب العمال الكردستاني يحلّ نفسه
ووفقاً لبيان صدر عن الحزب، واحتوى على قرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، الذي عقد الأسبوع الماضي، فقد تقرّر “حلّ البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح”، وبالتالي إنهاء الأنشطة العسكرية التي كانت تمارس في تركيا والعراق وسورية على حد سواء، تحت عنوان حزب العمال الكردستاني. وكانت وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الحزب، قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن الحزب عقد مؤتمره من 5 إلى 7 مايو/أيار الحالي “بنجاح”، وذلك “بناءً على دعوة القائد (مؤسس الحزب المسجون في تركيا) عبد الله أوجلان”، الذي دعا الحزب إلى حلّ نفسه وتسليم السلاح في فبراير/شباط الماضي.
وجاء في النصّ العربي للبيان الذي أصدره حزب العمال الكردستاني باللغات الكردية والتركية والإنكليزية والعربية، أمس، أن المؤتمر عُقد في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية، وشارك فيه 232 عضواً في اللجنة التنفيذية. وقال الحزب إن نضاله “كسر سياسات الإنكار والإبادة المفروضة على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحلّ عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية”. وأعلن أنه في هذا الإطار، “اتخذ قرار حلّ البنية التنظيمية لبي كا كا PKK (الجناح المسلح) وإنهاء الكفاح المسلح، على أن تتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان، منهياً بذلك الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم بي كا كا”، مؤكداً أن “القرارات التي اتُخذت في المؤتمر تشكّل انتقالاً قوياً إلى النضال السياسي الديمقراطي، وستسهم في تطوير مستقبل شعوبنا على أساس الحرية والمساواة”.
وشدّد البيان على أن قرار المؤتمر بـ”إنهاء الكفاح المسلح يُشكّل أرضية قوية للسلام الدائم والحلّ الديمقراطي، ويتطلب تنفيذ هذه القرارات أن يُمنح القائد أوجلان حق إدارة وتوجيه المرحلة، وأن يُعترف بحقّه في العمل السياسي، وأن تُوفّر ضمانات قانونية شاملة”، داعياً إلى أن “يتحمّل البرلمان التركي مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة”. ووجّه حزب العمال الكردستاني الدعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمعارضة، وجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات الدينية، والمؤسسات الإعلامية الديمقراطية، والشخصيات المجتمعية، والمثقفين، والأكاديميين، والفنانين، والنقابات العمالية، ومنظمات النساء والشباب، والحركات البيئية في الدولة التركية، إلى “تحمّل مسؤولياتهم والمشاركة في هذه المرحلة”.
وتعليقاً على الإعلان، اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البارزاني، أمس الاثنين، أن القرار سيعزّز “الاستقرار” الإقليمي بعد نزاع مسلّح استمر أربعة عقود. وقال البارزاني في بيان إن هذه الخطوة “تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة”. واعتبر أن هذا القرار يضع “أساساً لسلام دائم وشامل ينهي عقوداً من العنف والآلام والمعاناة”، مؤكداً استعداد إقليمه “الكامل للاستمرار في تقديم أي نوع من المساعدة والتعاون لإنجاح هذه الفرصة التاريخية”. ولطالما اتهمت تركيا ومسؤولون في حكومة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، حزب العمّال الكردستاني بالارتباط بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صاحب النفوذ التاريخي في السلطة في السليمانية بما فيها القوات الأمنية في المحافظة.
وقال مسؤول كردي في الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل، بزعامة مسعود البارزاني، لـ”العربي الجديد”، إن الإعلان عن حلّ الحزب وإنهاء العمل المسلح بعد قرابة عقود من الصراع المسلح داخل تركيا وخارجها، ستتبعه “اتفاقات على آليات التنفيذ”. ورأى أن “تفكيك الترسانة العسكرية لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق وخارجه، شرط أساسي بالنسبة لتركيا، التي تطلب تسليم هذه الترسانة لتدميرها، وكذلك الاتفاق على آلية اندماج عناصر الحزب في مجتمعاتهم الأصلية داخل تركيا، أو انتقالهم إلى دولة أخرى، وصولاً إلى آخر نقطة تتمثل بمشاركتهم في العملية السياسية، كلّها خطوات رئيسة ولا يوجد شيء ثانوي في الاتفاق”. وعلّق بـ”أننا أمام اتفاق تاريخي مهم، ستكون له ارتدادات على دول العراق وإيران وسورية وتركيا، معاً”.
وأضاف المسؤول الكردي طالباً عدم الكشف عن هويته: “نتحدث عن ترسانة عسكرية ضخمة ومقاتلين ومنشآت قائمة منذ سنوات طويلة في العراق، لذا لا يتوقع أحد أن الموضوع سيكون سريعاً، وقد تأخذ الإجراءات فترة زمنية طويلة، لكن ما تحقق اليوم (أمس) تاريخي”، مُرجحاً أن تُعلن أنقرة عن “وضع جديد” لقائد “الكردستاني” عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، ضمن ما قال المسؤول إنها “تفاهمات مسبقة”. لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى “أهمية عدم الإفراط بالتفاؤل في كون ورقة العمّال قد طويت، إذ إن الحزب عقائدي، وقد تنجم عنه انشقاقات أو جيوب رافضة لتنفيذ مقررات المؤتمر”.
السياسي العراقي الكردي والمختص في شؤون حزب العمال الكردستاني، شيخوان عقراوي، قال لـ”العربي الجديد”، إن ما تحقق تمّ بناء على “ضمانات تركية مهمة قدّمت للحزب”، مضيفاً أن “الدولة التركية كانت تفاوض من جهة وتُصعّد من ضغطها العسكري على الحزب في العراق” من جهة أخرى. وأضاف: “سيكون أمام منظومة حزب العمال الكردستاني المالية التي تنشط في أوروبا والعراق وسورية، حلّ نفسها، والكشف عن ذممها المالية أسوة بترسانة الحزب العسكرية”، ولفت إلى أن “الجيل الجديد من حزب العمّال، الذين صاروا ينتقلون إلى مراتب قيادية، كان لهم دور في صياغة هذا الاتفاق”.
وتُقدر نسبة المقاتلين من حملة الجنسية التركية في حزب العمال الكردستاني بنحو 80%، وهؤلاء وفقاً لعقراوي، تمتلك أنقرة قاعدة بيانات كاملة عنهم وتلاحق المتورطين منهم بأعمال إرهابية، أما الآخرون، فهم عراقيون وسوريون وإيرانيون. وتوقع أن تعقب الإعلان، تفاهمات ذات طبيعة استخبارية عسكرية، ستدخل الحكومة العراقية طرفا فيها على اعتبار أنها تجري على الأراضي العراقية، وتتركز على خطوات تسليم السلاح، وهو شرط أساسي تركي، كما جرى تسريب المعلومات حول الاتفاق منذ ليل الأحد – الاثنين.
وحول مصير مسلحي الحزب، توقع عقراوي “أن يتم العفو من الدولة التركية، عن الذين لا سجلات إرهاب وعنف ضدهم عند السلطات التركية، وهؤلاء سيعودون بشكل تحدّده تركيا ذاتها، أما الآخرون، فقد يُصار إلى اختيار دولة ثالثة، وهم المتورطون بهجمات كبيرة، وأعني بهم قادة الجناح العسكري للحزب، أو أن يُصار إلى بقائهم في العراق هم وأسرهم”، مُتحدثاً عن “دول أوروبية قد تقبل لجوء عدد من المطلوبين المتورطين بعمليات عسكرية مباشرة”. وأشار إلى أن ما لا يقل عن ألفي مقاتل من حزب العمال الكردستاني ممن يوجد أغلبهم في العراق، يواجهون ملفات قضائية متعلقة بأعمال إرهابية، أو أنشطة مخالفة، وهؤلاء تتفاوت أوضاعهم وليسوا بدرجة واحدة من التورط بأعمال الحزب خلال السنوات الماضية.
لكن عقراوي لفت إلى أن “هذا الإعلان معرض لأن ينهار في حال الإخلال بأي من التفاهمات التي على أساسها تم أخذ قرار تفكيك الحزب وإنهاء العمل المسلح، بما فيها السماح لكوادر الحزب بممارسة العمل السياسي في تركيا”، وفقاً لرأيه.
واقع الحزب داخل الخريطة العراقية
منذ عام 1984 توجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد من وجوده بعد الغزو العراقي للكويت (1990) وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد، عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق (2003)، تحولت مدن ومناطق كاملة شمالي العراق إلى معاقل رئيسة لـ”الكردستاني”، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل بالعمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية، حتى عام 2013.بعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق (2014)، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك، عام 2014، تحت عنوان حماية الأيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها “الكردستاني”، أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع.
أبرز معاقل الحزب، هي سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني، فيشخابور، ضمن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى.
ويُقدر حالياً عدد مقاتلي الحزب الكلّي بأكثر من ستة آلاف مقاتل (ليس هناك إحصاء دقيق، وهناك تقديرات بأنه عددهم كان يفوق عشرة آلاف، وتناقص منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي)، مع ترسانة سلاح تشمل مضادات طائرات مروحية، وصواريخ أرض ـ أرض، وقذائف حرارية وأسلحة ثقيلة متنوعة وأخرى متوسطة، تنتشر بعضها على قمم جبال استراتيجية ومهمة بين العراق وتركيا، أبرزها سلسلة جبال برزان ومتين. وأكد الخبير في الشأن السياسي الكردي، شاهو القرة داغي، أن عدد المقاتلين الفعلي داخل العراق، لا يتجاوز أربعة آلاف مقاتل من “الكردستاني”، وهناك أعداد أخرى في سورية، ضمن التنظيم ذاته. ولفت في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن العدد يبقى تقريبياً، لأنه لا توجد إمكانية حقيقية لإحصائهم لكن البعض صار يضيف مدنيين من أكراد تركيا موجودين في مخيم مخمور، إلى إجمالي العدد، رغم أن لا علاقة تنظيمية لهم بالحزب.
وأسّس حزب العمال الكردستاني، عام 2016، في مدينة سنجار (110 كيلومترات غرب الموصل)، أذرعاً محلية، وهي عبارة عن مليشيات من الأيزيديين العراقيين وآخرين أكراد، وأبرزها: مليشيا “وحدات حماية سنجار”، المعروفة محلياً بمليشيا “أيزيدي خان”، ومليشيا “لالش”، وتنشط جميعها في سنجار وضواحيها وترفع شعارات وصور “الكردستاني”.
وتقطن عائلات الحزب المقدرة بنحو 1800 عائلة في مخيم مخمور بمحافظة نينوى، على الحدود مع أربيل، وهو المخيم الذي اعتبرته تركيا عام 2020 موقعاً غير مدني، وقالت إنه تحول إلى معسكر تدريب وتجنيد لمقاتلي الحزب.
في المقابل، يبلغ عدد القواعد والثكنات والمعسكرات التركية الدائمة داخل العراق، نحو 80 موقعاً، وبعديد جنود يبلغ أكثر من خمسة آلاف عسكري تركي داخل العراق. أبرز تلك القواعد هي معسكر بعشيقة، والزاب، ومتين، وسوران، ومهبط طائرات قديم في أطراف دهوك، طورته القوات التركية ليكون قاعدة لها منذ عام 2018، وجميعها ضمن عمق يتعدى 30 كيلومتراً داخل العراق، لكن فعلياً فإن النشاط الاستخباري التركي يتعدى إلى 50 كيلومتراً، حيث يتم تنفيذ عمليات إنزال واغتيالات، خصوصاً في مناطق قرب السليمانية. وتقول أنقرة إنها تتمركز في العراق، من باب دفاعي، وترفض الانسحاب ضمن ما تسمّيه حقّ صد الهجمات التي يشنها حزب العمّال الكردستاني انطلاقاً من العراق، وتطالب بغداد، بالعمل على منع تحول أراضي العراق إلى معاقل عسكرية موجهة ضدها، لقاء انسحابها، وهو ما لم تتفق عليه بغداد وأربيل منذ عام 2003.
تفاؤل حذر
العميد المتقاعد في قوات البشمركة الكردية بالعراق، علي آغا، اعتبر في حديث لـ”العربي الجديد”، أن انسحاب حزب العمال الكردستاني من المناطق التي يوجد فيها، يعني عودة أكثر من 250 ألف عراقي كردي إلى المناطق التي نزحوا منها قبل سنوات طويلة، بسبب المواجهات العسكرية والقصف في المناطق التي كانوا يسكنونها إثر دخول “الكردستاني” إليها. وأضاف آغا أن “تغييرات أمنية وسياسية واجتماعية تنتظر إقليم كردستان ونينوى وكركوك، في حال ترجمة حلّ حزب العمّال الكردستاني لنفسه إلى واقع عملي، والعراق يُنافس تركيا في مدى التأثر الإيجابي الذي ألحقه هذا القرار”. لكنه توقع أن نزع السلاح وتجريده، لن يكون سهلاً، وأن الجناح القومي اليميني الأكثر تطرفاً في “الكردستاني”، وهم المعروفون بـ”جناح قنديل”، غير موافق على هذه الخطوة، وقد يحدث تمرد داخلي، لكن الأكثرية وصلوا إلى قناعة استحالة الانفصال بدولة كردية تُنتزع من الدولة التركية التي قامت بعد نهاية الحقبة العثمانية، وفقاً لقوله. واعتبر أن “العمل المسلح لحزب العمال، هو من أوصل إلى الاعتراف بحقوق كردية قومية واجتماعية وسياسية، ولفت الأنظار إليها، وبالتالي يمكن ممارستها داخل الدول الأربعة (العراق وسورية وتركيا وإيران)”، بحسب اعتقاده.
من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني العراقي، عقيل الطائي، إن بغداد ستجني منافع أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة من القرار، مضيفاً في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الإعلان يعني عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سنجار وضواحيها، ومخمور وزمار، وأيضاً انسحاب القوات التركية من العراق، وعودة أكراد العراق النازحين الذين يقدرون بعشرات آلاف العائلات من قراهم ومدنهم الحدودية في إقليم كردستان”.
وشرح أن الطريق البرّية بين العراق وتركيا، ستعود للتجارة والتنقل كما كانت قبل عقود، ومنها مشروع طريق التنمية الذي تسعى إليه بغداد وأنقرة، متوقعاً أن تستمر إجراءات الحل لغاية نهاية العام الحالي “في حال عدم حدوث خلل بالاتفاق، بسبب التاريخ الطويل من النكث بالتفاهمات بين الدولة التركية والحزب”.
(شارك بالتغطية من بغداد محمد علي)
————————————-
الإدارة الذاتية: مشروع أوجلان يمثّل حلاً جذرياً لأزمات الشرق الأوسط
2025.05.13
قالت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إن رؤية ومشروع عبد الله أوجلان يشكّل حلاً جذرياً لمعضلات الشرق الأوسط، ويستند إلى مبادئ السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت الإدارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن المشروع الذي طرحه أوجلان لا يقتصر على معالجة القضية الكردية فقط، بل يقدّم نموذجاً متكاملاً من خلال مفهوم الأمة الديمقراطية، وأخوّة الشعوب، وحرية المرأة، وحماية البيئة.
ودعت الإدارة الذاتية شعوب المنطقة إلى التكاتف والالتفاف حول هذه “الخطوة التاريخية”، والعمل على ترسيخ القيم الديمقراطية المشتركة باعتبارها الضامن لبناء مجتمع تعددي يرفض كل أشكال الاستبداد.
“رسالة تاريخية”
وفي شهر شباط الماضي، أشار أوجلان في نداء له إلى أن حزب العمال الكردستاني نشأ في ظروف القرن العشرين، التي وصفها بأنها “الأكثر عنفاً في التاريخ”، مشيراً إلى الحربين العالميتين، الحرب الباردة، وإنكار الهوية الكردية.
وقال: “تأثّر الحزب بالنظام الاشتراكي الواقعي في استراتيجيته وبرامجه، إلا أن انهيار الاشتراكية في التسعينيات والتطوّرات الحاصلة في حرية التعبير أفقدته معناه، وأدّى إلى تكرار مواقفه بشكل مفرط. ولذلك، فإن الحزب، كغيره من الحركات المشابهة، استكمل دوره وأصبح حلّه ضرورياً”.
وفي الجزء الأخير من ندائه، شدد أوجلان على ضرورة احترام الهويات وحرية التعبير والتنظيم الديمقراطي، كجزء من بناء مجتمع سياسي ديمقراطي، معتبراً أن “القرن الثاني للجمهورية التركية لن يحقّق استمرارية دائمة وأخوّة إلا إذا تُوّج بالديمقراطية”.
وتابع قائلاً: “لا يوجد، ولا يمكن أن يكون، طريق لتحقيق التغيير خارج إطار الديمقراطية، حيث يجب أن يكون التوافق الديمقراطي هو الأساس، كما ينبغي تطوير لغة السلام بما يتناسب مع الواقع”.
كما أعلن تحمّله المسؤولية التاريخية لدعوته إلى التخلي عن السلاح، مستشهداً بالدعوة التي وجّهها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والمواقف الإيجابية التي أبدتها الأحزاب السياسية الأخرى، إلى جانب التوجّه الذي أبداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف: “كما تفعل كل المجتمعات والأحزاب التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اجتمعوا في مؤتمر واتخذوا قراراً بالاندماج مع الدولة والمجتمع. يجب أن تضع جميع المجموعات السلاح، ويجب أن يُعلن عن حلّ حزب العمال الكردستاني”.
حلّ حزب العمال الكردستاني
قرر حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإنهاء تمرده المسلح في تركيا، في خطوة من شأنها أن تُحدث تحولات سياسية وأمنية كبيرة في المنطقة.
وأفادت وكالة “فرات” للأنباء، المقرّبة من الحزب، يوم أمس الإثنين، أن حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعاً مسلحاً مع الدولة التركية منذ أكثر من أربعين عاماً، قرر بشكل رسمي حلّ نفسه ووقف تمرده المسلح.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء في ختام مؤتمر عقده الحزب الأسبوع الماضي في شمالي العراق، تلبيةً لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، الذي كان قد دعا في شباط الماضي إلى إنهاء التنظيم نفسه.
وتوقعت مصادر سياسية أن يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات إقليمية واسعة، لا سيما في سوريا المجاورة، حيث تتمركز “قوات كردية” متحالفة مع الجيش الأميركي، وفقاً لما نقلته “رويترز”.
يُذكر أن الصراع بين الحزب والدولة التركية بدأ عام 1984، وأسفر منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، علماً أن تركيا ومعظم الدول الغربية تُصنّف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
—————————-
“بداية مرحلة جديدة من السلام”.. مظلوم عبدي يرحب بحلّ حزب العمال الكردستاني
2025.05.13
رحب قائد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، مظلوم عبدي، بحلّ حزب العمال الكردستاني وإيقاف العمل المسلح، معتبراً أن هذا القرار يمثل بداية لمرحلة جديدة من السلام في المنطقة.
وقال عبدي: “إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل بنيته التنظيمية، وإنهاء الكفاح المسلح، والبدء باتباع السياسة الديمقراطية بناءً على نداء القائد عبد الله أوجلان، محل تقدير”.
واعتبر عبدي في تغريدة على منصة “إكس” أن حزب العمال الكردستاني كان له “دور تاريخي في الشرق الأوسط خلال المرحلة المنصرمة”.
وأضاف: “كلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، كما نأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة، وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب”.
حلّ حزب العمال الكردستاني
قرر حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإنهاء تمرده المسلح في تركيا، في خطوة من شأنها أن تُحدث تحولات سياسية وأمنية كبيرة في المنطقة.
وأفادت وكالة “فرات” للأنباء، المقرّبة من الحزب، يوم أمس الإثنين، أن حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعاً مسلحاً مع الدولة التركية منذ أكثر من أربعين عاماً، قرر بشكل رسمي حلّ نفسه ووقف تمرده المسلح.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء في ختام مؤتمر عقده الحزب الأسبوع الماضي في شمالي العراق، تلبيةً لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، الذي كان قد دعا في شباط الماضي إلى إنهاء التنظيم نفسه.
وتوقعت مصادر سياسية أن يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات إقليمية واسعة، لا سيما في سوريا المجاورة، حيث تتمركز “قوات كردية” متحالفة مع الجيش الأميركي، وفقاً لما نقلته “رويترز”.
يُذكر أن الصراع بين الحزب والدولة التركية بدأ عام 1984، وأسفر منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، علماً أن تركيا ومعظم الدول الغربية تُصنّف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
————————
“حرييت”: تفاصيل تسليم حزب العمال الكردستاني لسلاحه بحضور المخابرات التركية
جابر عمر
13 مايو 2025
قالت صحيفة حرييت التركية، اليوم الثلاثاء، إن نقاطاً ستُنشأ من أجل تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه، في الدول التي يوجد فيها بحضور المخابرات التركية بعد إنشاء قاعدة بيانات بالأسلحة. وأوضحت الصحيفة أن مؤسس الكردستاني عبد الله أوجلان كانت تعليماته واضحة لقيادة الحزب باتخاذ ما يلزم، وقد تستغرق عملية تسليم الأسلحة أربع سنوات وفق النموذج الأيرلندي، في ظل مساع لتسريع هذه المرحلة.
وكشفت “حرييت”، أن هذه المرحلة ستكون سرية، وستُحدد نقاط عديدة من أجل عملية التسليم، وتشمل مسؤولي البلاد في تلك الدولة مع عناصر المخابرات التركية، وستُسجّل بيانات الأسلحة ومن أين جاءت، كما أن الكردستاني عمل على قاعدة بيانات بالأسلحة التي يمتلكها.
وعقب التسليم والتحقق منها ستُبلغ مؤسسات الدولة في تركيا، كما أن هذه المرحلة لن تشهد مشاركة دول أخرى أو منظمات أممية، حيث كانت ادعاءات تقول بإشراف أممي على هذه المرحلة.
وفي ما يخص الإجراءات القانونية بعناصر الكردستاني المستسلمين فإن الجهود مستمرة لتحديد المسارات المختلفة للتعامل معهم، منها المسار الحالي، فالعناصر المستسلمون الذين لم تُسجل بحقهم أي جرائم ستُأخذ إفادتهم ويُتركون، وتشير التقديرات إلى أن 60% من العناصر في العراق لم يُسجل بحقهم جرائم بعد.
وأضافت الصحيفة أن من سجل بحقه جرائم سيُعاقب بالحد الأدنى من القوانين النافذة من دون إقرار قوانين جديدة.
أما بخصوص القيادات الرفيعة المطلوبة بالنشرة الحمراء وتشمل 30 اسماُ فلن يُسمح لهم بالعودة إلى تركيا ويخيّرون ما بين البقاء في البلدان التي هم فيها أو مغادرتها إلى بلدان أخرى.
ويبقى التساؤل بحسب الصحيفة عن مستقبل الحزب المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا وخارجها، وهنا سيكون للقضاء دور وقد تصدر الأحكام بحقهم وفق عبارة “تنظيم إرهابي انتهى”، فيما سيواصل أوجلان بقاءه في محبسه في الوقت الحالي، وبعد انتهاء مرحلة جمع السلاح ستبدأ مرحلة التعديلات الدستورية.
وفي ما يخص سورية قالت الصحيفة إن تركيا تفضل أن تُحل مسألة التنظيم في سورية بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية وفق الاتفاق الموقع بين الجانبين ودمج الوحدات الكردية داخل الجيش السوري الجديد، في إطار وحدة سورية من دون أي تنازل بمسألة أي نظام فيدرالي.
من جانبها، قالت قناة سي أن أن التركية أن المؤسسات المعنية في تركيا تعمل على إعداد تقارير تقدّم للرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص المرحلة المقبلة بعد المعلومات التي ستأتي من الميدان والخطوات المقبلة، وبناء عليه يصدر الرئيس أردوغان قراره للمرحلة التالية.
وأعلن أمس حزب العمال الكردستاني قرار حل تنظيمه وإلقاء السلاح وفق مقررات المؤتمر العام الذي عقد في 5-7 من الشهر الجاري، استجابة لدعوة أطلقها مؤسس الحزب من محبسه عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير الماضي في مرحلة تسميها الحكومة في تركيا بأنها مرحلة “تركيا بلا إرهاب”، وانطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
————————————
مواقف كردية سورية من قرار حلّ العمال الكردستاني/ سلام حسن
13 مايو 2025
توالت ردود الفعل في الأوساط الكردية السورية، من أحزاب، ومنظمات، وشخصيات سياسية وثقافية مؤثرة، عقب إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، وإلقاء السلاح خلال مؤتمره الأخير.
وأصدر المجلس الوطني الكردي في سورية بياناً، اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن متابعته “باهتمام بالغ” للتطورات المتعلقة بإعلان الحزب وقف العمل المسلح، وحلّ نفسه، استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان. واعتبر المجلس أن الخطوة “تمثل تحولاً سياسياً مهماً وإيجابياً من شأنه الإسهام في تعزيز فرص السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة عموماً”، مشيداً بالتوجه نحو المسار السلمي، ومعتبراً إياه “فرصة حقيقية لإطلاق عملية سلام جادة، تُفضي إلى حل سياسي شامل للقضية الكردية في تركيا، يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ضمن إطار ديمقراطي ودستوري”.
وأكد المجلس دعمه لكل جهد يصبّ في إنهاء الصراعات وتحقيق تطلعات الشعب الكردي، معبّراً عن أمله في أن “تواكب هذه الخطوة مبادرات بنّاءة وجادة من قبل الدولة التركية، وكافة الأطراف المعنية، بما يضمن نجاح عملية السلام واستدامتها”. وختم البيان بتأكيد أن “دعم المسارات السلمية كان ولا يزال خياراً مبدئياً”، معتبراً أن استقرار تركيا يخدم المصالح المشتركة لشعوب ودول المنطقة.
من جهتها، أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، بياناً، اليوم الثلاثاء، اعتبرت فيه أن “مشروع القائد عبد الله أوجلان يُعد مشروعاً تاريخياً وحلاً جذرياً لمعضلة الشرق الأوسط، يقوم على أسس السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”. ورأت أن المشروع يمثل حجر أساس لتحقيق تأثير مهم على الواقع السوري، لا سيما في مناطق شمال وشرق سورية، حيث ساهم في “تعزيز السلام الداخلي، وترسيخ مفهوم التعايش المشترك بين مختلف المكونات”. وأكدت الإدارة أن التجربة في مناطقها أثبتت أن المشروع يُسهم في بناء نموذج ديمقراطي “يعكس تطلعات الشعوب، ويمنحها دوراً فعالاً في إدارة شؤونها بإرادتها الحرة”.
ورحّب قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بالقرار، وقال عبر منصة “إكس”: “قرار حزب العمال الكردستاني بحل بنيته التنظيمية، وإنهاء الكفاح المسلح، والبدء باتباع السياسة الديمقراطية بناء على نداء القائد عبد الله أوجلان، محل تقدير”. وأضاف: “كان للحزب دور تاريخي في الشرق الأوسط خلال المرحلة المنصرمة، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة”، معرباً عن أمله في أن “تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وتقديم الدعم المطلوب”.
كما رحّب سكرتير حزب يكيتي الكردستاني، سليمان أوسو، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، بقرار الحزب، واصفاً إياه بـ”الخطوة بالغة الأهمية على طريق إنهاء عقود من العنف، بما يهيئ الأرضية لانطلاقة مرحلة جديدة تُسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة”. وأكد أوسو أهمية تعاون جميع الأطراف لإنجاح مسار السلام، “بما يخدم مستقبل الشعوب واستقرار المنطقة”.
وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978 في تركيا على يد مجموعة من الطلاب اليساريين، من بينهم عبد الله أوجلان. وبعد عامين، لجأ أوجلان إلى سورية في عهد الرئيس حافظ الأسد، عقب حملة اعتقالات وإعدامات طاولت مؤسسي الحزب. واستقر أوجلان في سورية لسنوات، حتى تمكنت تركيا من الضغط على النظام السوري لإخراجه، ليُعتقل لاحقاً في 15 فبراير/ شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، ويُنقل بطائرة خاصة إلى أنقرة حيث خضع للمحاكمة.
وقد أعلن الحزب الكفاح المسلح ضد الدولة التركية منذ عام 1984، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وخلال مسيرته، وسّع حزب العمال الكردستاني نفوذه ليشمل تركيا وسورية والعراق وإيران، وأسّس فروعاً في العديد من الدول. وقد اعتمد في عمله التنظيمي على كوادره المباشرة، أو من خلال تشكيل أحزاب ومنظمات محلية تابعة له تنظيمياً. ورغم الطابع الكردي للحزب، فهو يضم في صفوفه عناصر من أصول عربية وتركية وفارسية، إضافة إلى مقاتلين أجانب من أوروبا وأميركا الشمالية واللاتينية.
————————–
“حكاية” حزب “العمال الكردستاني” و”الكفاح المسلح”… هل انتهت؟/ رستم محمود
الأسئلة الأمنية والسياسية والتشريعية بشأن الخطوات القادمة غامضة للغاية
آخر تحديث 13 مايو 2025
بعد مسيرة امتدت لقرابة نصف قرن، أعلن حزب العمال الكردستاني “حل نفسه” و”إنهاء الكفاح المسلح”. ففي مؤتمر استثنائي عُقد في معسكر الحزب بجبال قنديل الواقع في المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وإيران، بين 5-7 من الشهر الجاري، استجابة لدعوة زعيمه المُعتقل عبد الله أوجلان، ضمن سياق الدعوة التي وجهها زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي أواخر العام الماضي، والتي تمهد حسب المراقبين إلى إيجاد “حلول سياسية” للمسألة الكردية في تركيا، استباقا لما تصنفه أوساط “الدولة العميقة” في تركيا تحولات إقليمية جذرية في المنطقة.
جدال داخلي
إعلان “حزب العمال الكردستاني” جاء عقب أسابيع من المداولات السياسية الصاخبة التي شهدتها تركيا. ففي الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تقدم زعيم الحركة القومية التركية بهجلي من كتلة حزب “ديمقراطية الشعوب” المؤيد للحقوق الكردية ضمن البرلمان التركي وصافح أعضاء الحزب، بعد سنوات كثيرة من المقاطعة الجذرية والصراع المحتدم بين الحزبين، ما اعتبره المراقبون دلالة على تحول سياسي جوهري في البلاد. وبعد أيام قليلة، وجه رئيس الحركة القومية التركية نداء إلى زعيم حزب “العمال” عبد الله أوجلان، مطالبا إياه بالقدوم إلى البرلمان وإعلان حلّ الحزب وإيقاف الكفاح المسلح.
أحدث التصريح “زلزالا” سياسيا في تركيا. فالحكومة والرئيس أردوغان أظهرا تحفظات متتالية على دعوة بهجلي، لكن الأخير، وبصفته “ممثلا عن الدولة العميقة في تركيا” كما هو متداول، أكد أن مسألة العلاقة مع “العمال الكردستاني” تتعلق بـ”الدولة التركية وليس الحكومة”. على أثر ذلك تشكلت لجنة من حزب “الشعوب الديمقراطية” المؤيد لحقوق الأكراد، واجتمعت مع زعيم الكردستاني أكثر من مرة، وقالت الأنباء إنها سافرت إلى جبال قنديل واجتمعت بالقيادة الميدانية لـ”الكردستاني”.
وفي التاسع من شهر مارس/آذار المنصرم أصدر أوجلان نداء إلى قادة حزبه، داعيا إياهم للاجتماع وإعلان إنهاء الكفاح المسلح وحل الحزب. قادة “الكردستاني” أبدوا تحفظات تجاه النداء، مطالبين بمزيد من الضمانات، بما في ذلك لقاء أوجلان. زعيم الحركة القومية التركية طالب الحزب بعقد مؤتمره داخل تركيا، تحديدا في مدينة “ملاذكرد” بولاية موش شرقي البلاد، في إشارة ضمنية إلى التحالف التاريخي الذي جمع الأكراد والأتراك، انطلاقا من تلك المعركة الشهيرة التي حدثت عام 1071.
لكن نقاشات واجتماعات سياسية مطولة، أجراها وفد حزب “ديمقراطية الشعوب” بين أوجلان وقيادة “الكردستاني” والرئيس أردوغان وزعيم “الحركة القومية”، سمحت بتقادم تلك العملية ببطء، إلى أن وصلت لهذه النتيجة النهائية.
غموض مُقلق
البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي لحزب “العمال لكردستاني” تضمن تلخيصا بيوغرافيا للسيرة السياسية والأيديولوجية للحزب، معتبرا معاهدة لوزان ودستور عام 1924 اللذين أنكرا وجود الشعب الكردي جذر المسألة الكردية في تُركيا، حيث رُد عليها بكفاح مستمر من الانتفاضات الكردية، كانت تجربة حزب “العمال الكردستاني” آخرها، ودامت 52 عاما، حسب مضمون بيان المؤتمر.
لكنه فسّر حل الحزب وإنهاء الكفاح المسلح كخطوة في سبيل “حل قضية الكرد في الوطن المشترك والمواطنة المتساوية… من خلال إعادة تنظيم العلاقات الكردية- التركية، والنضال الديمقراطي وصولا إلى بناء المجتمع الديمقراطي”، وليس كأي استسلام أو خضوع لمطالب وضغوط الدولة التركية.
لكن اللافت في نتائج مؤتمر “العمال الكردستاني” هو إيحاؤه بالملمح الكلي لما يحاول التوصل إليه من معالجات سياسية/دستورية في المستقبل، بعد ترك الكفاح المسلح “من الضروري أن يشكل شعبنا، بقيادة النساء والشباب، منظماته الذاتية في كل مجالات الحياة، وأن ينظم ذاته على أساس الاكتفاء الذاتي بلغته، وهويته، وثقافته، وأن يصبح قادرا على الدفاع عن نفسه ضد الهجمات، وأن يبني المجتمع الديمقراطي الجماعي بروح التعبئة. وبهذا الأساس، نؤمن بأن الأحزاب السياسية الكردية، والمنظمات الديمقراطية، ورواد الرأي سينجزون مسؤولياتهم في تطوير الديمقراطية الكردية وتحقيق الأمة الديمقراطية الكردية”.
ومع تلك التحديدات، وما لاقاها من تصريحات حكومية وسياسية تركية نظيرة، والتي قالت في مجملها إن حل “العمال الكردستاني” لنفسه وإنهاء الكفاح المسلح سيفتح الباب أمام مزيد من “الانفتاح السياسي”، تبقى الأسئلة الأمنية والسياسية والتشريعية بشأن الخطوات القادمة غامضة للغاية، خلا بعض التوقعات التي يتم تداولها من قِبل مقربين من الطرفين.
إذ ليس واضحا إن كان أي اتفاق سياسي بين زعيم الحزب المعتقل والدولة التركية قد حدث. فهذه الأخيرة تنفي وجود أي شيء من ذلك القبيل، لكن المصادر الكردية تصر على استحالة استجابة أوجلان لمثل هذه الدعوة دون ضمانات أولية وواضحة من ذلك القبيل، خصوصا في مسائل مثل مستقبل الاعتراف بالأكراد دستورياً وتوسيع التعليم باللغة الكردية. ويُردف مناصرو “الكردستاني” أن ذلك كان مستحيلا في أزمنة سابقة، حينما كان الحزب في أضعف أوضاعه الجيوسياسية وأكثرها حرجا، فكيف به الآن، والمنطقة كلها مُقدمة على تحولات جذرية؟
المسألة الأخرى تتعلق بآلية تنفيذ عملية تفكيك البنية المسلحة للحزب، سواء في القواعد الثابتة المتمركزة على قوس جبلي يتجاوز طوله 400 كيلومتر، أو نوعية الأسلحة الفتاكة التي بيد المقاتلين، أو حتى تنظيماته العسكرية المحلية، في المدن الداخلية لتركيا. مصدر سياسي كردي كشف في حديث مع “المجلة” عما أسماه التوافق المبدئي بشأن ذلك التفصيل، والمتضمن تشكيل لجنة ثلاثية، وربما رباعية، مؤلفة من تركيا والعراق (متضمنا إقليم كردستان) و”العمال الكردستاني”، مع وجود غير رسمي للولايات المتحدة، تشرف على آلية ضبط عشرات الآلاف من قطع السلاح وتجميعها، وتفكيك البنية الجبلية العسكرية المعقدة، التي شيدها الحزب خلال نصف قرن كامل، وفي أكثر المناطق الجبلية وعورة.
المصدر أضاف في حديثه مع “المجلة” قائلا: “المستقبل السياسي والقانوني لآلاف مقاتلي (الكردستاني) وساسته سيكون أصعب من تفكيك البنية العسكرية. فهل سيحق لهؤلاء الدخول في بنية العمل السياسي من خلال الحزب المؤيد للأكراد، أو حتى تأسيس حزب غيره؟. وهل سيبقى هؤلاء المقاتلون محل نبذ سياسي وقانوني من مؤسسات الدولة والقوى السياسية، أم ستصدر تشريعات حامية لهم. الأمر نفسه ينطبق على القراءة المشتركة والرسمية التي سيتفق عليها الطرفان بشأن ما حدث خلال نصف قرن كامل مضى: فهل كانت مواجهة بين الدولة التركية ومنظمة إرهابية، كما تقول الدعاية التركية منذ سنوات؟! أم كان كفاحا مسلحا خاضه (العمال الكردستاني) لنيل الاعتراف والحقوق الطبيعية للكُرد في تركيا؟ فهذا التفصيل سوف يبنى عليه كل ما هو لاحق من سياقات”.
تعقيبا على قرار “الكردستاني”، قال مسؤول دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: “سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مضي عملية حل حزب (العمال الكردستاني) بشكل سلس”. فيما رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بالحدث، واعتبره “خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة في المنطقة، ويعكس نضجا سياسيا ويمهد الطريق لحوار حقيقي، فهذه الخطوة تنهي عقودا من العنف والمعاناة وتقود المنطقة نحو آفاق جديدة من التقدم، وتعبر عن استعدادنا الكامل للاستمرار في تقديم أي مساعدة ودعم لإنجاح هذه الفرصة التاريخية”. ومن المتوقع أن تصدر الكثير من الجهات الدولية والإقليمية ترحيبا بالموضوع، تحديدا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مثلما فعلت أثناء توجيه أوجلان لندائه.
هل انتهت “حكاية السلاح”؟
لا يُظهر المراقبون الأكراد تفاؤلا مفتوحا بالمجريات الحالية، وغالبيتهم تميل للحذر من الخطوات المستقبلية، التي قد تطيح بكل شيء، وتُرجع الأمور “أسوأ” مما كانت عليها، كما يشرح الباحث في مركز الفرات للدراسات وليد جليلي في حديثه مع “المجلة”. ويضيف: “لا يتطلب الأمر الكثير من الحصافة للقول إن المسألة الكردية في تركيا هي من أنتجت الصراع المسلح، وليس العكس. أي إن إنهاء الصراع المسلح لن يعني بالضرورة نهاية القضية الكردية، أو حتى إمكانية اندلاعها بعنف وجذرية أكبر. فالشهور القادمة، ستُظهر إن كانت الدولة العميقة في تركيا، ممثلة راهنا بتحالف حزبي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية) مع المحفلين العسكري والاستخباراتي، هل ستكون قادرة على ملاقاة مبادرة (الكردستاني) سياسيا وتشريعيا أم لا. لأن عدم حدوث ذلك، سيفتح الأبواب واسعة أمام خيبة أمل متجددة في الأوساط الكردية، وهؤلاء بعشرات الملايين في الداخل التركي، وقد يتسبب ذلك بعنف من أشكال مختلفة، مدني وشعبي على الأغلب”.
ويضيف الباحث وليد الجليلي المختص بالشؤون الأمنية: “في تتبع سيرة حزب (العمال الكردستاني)، يبدو واضحا أن الكفاح المسلح لم يكن خيارا أوليا وجذريا مطلقا بالنسبة له. فمنذ تأسيسه في عام 1978 وحتى عام 1984 لم يمارس الحزب أي نشاط مسلح، بل كان يستند إلى وعي سياسي ثوري/ماركسي، يؤمن بأن الانتفاضات الشعبية قادرة على إجبار السلطات الحاكمة على القبول بالتفاوض ومنح الحقوق. وحتى مع مرحلة الصراع المسلح المفتوحة (1984-1999)، أي إلى حين اعتقال زعيم (العمال الكردستاني)، فإنه أعلن وقفا لإطلاق النار من طرف واحد لعشرات المرات، ولم يحدث أن انزاح لأي وهمٍ بأن المسألة الكردية يُمكن حلها من خلال العنف والقسر، بل كان يؤكد أن هذه الأخيرة هي للدفع والتأثير ليس إلا، على الرغم من فظاعة الانتهاكات التي طالت مقاتليه أو قواعده الاجتماعية. منذ عام 1999، لم يمارس (العمال الكردستاني) الهجمات المسلحة إلا نادرا، وبغرض التذكير بوجود المسألة الكردية ضمن النقاش السياسي العام في البلاد ليس إلا. كذلك غيّر جذريا من طبيعة أيديولوجيته ونزعاته السياسية، من تنظيم سياسي كان يطالب بتقسيم تركيا وتأسيس دولة كردستان الكبرى، وصولا للقبول بتشكيل دولة ديمقراطية تعترف بالكرد في تركيا. هذه التحولات التي آن للدولة التركية ملاقاتها، ولو قبل منتصف الطريق بمسافة طويلة، ولو لم يحدث، فإن الحكاية ستبدأ من جديد”.
المجلة
————————-
=========================
=======================
الحكومة السورية الانتقالية: المهام، السير الذاتية للوزراء، مقالات وتحليلات تحديث 13 أيار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
—————————–
فوضى دمج المناطق السورية/ عبسي سميسم
11 مايو 2025
لا تزال الحكومة السورية، منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تُعاني من مسألة دمج المناطق التي تسيطر عليها حتى الآن ضمن نظام إداري وأمني وعسكري متجانس. واعتمدت الحكومة تعميم تجربة إدلب على باقي المناطق السورية، ما أدى إلى اصطدام هذا التعميم بالكثير من العقبات على جميع المستويات، التي حاولت تجاوزها بإجراءات أخذ بعضها طابعاً ارتجالياً، رغم تشكيل الإدارة الجديدة حكومةً انتقاليةً أقرب لحكومة التكنوقراط. إلا أن تلك الحكومة بدأت تظهر في بعض أدائها كواجهة لمجموعة من المتحكمين من الكتلة الصلبة لـ”هيئة تحرير الشام” سابقاً، خصوصاً أولئك الذين كانوا يديرون ملفات أيام حكومة الإنقاذ في إدلب، والذين أدى استمرارهم في إدارتها على مستوى سورية بعد تحرير البلاد إلى مخالفات قانونية ودستورية، كأن يؤدي استمرار وزير “من الكتلة الصلبة للهيئة” بمتابعة ملف ما كان مسؤولاً عنه في إدلب إلى تعدّيه على اختصاصات وزراء آخرين من حكومة التكنوقراط.
على المستوى الإداري، دفع الاختلاف في مناهج التعليم والنظم الإدارية بين المناطق السورية، على سبيل المثال، إلى إعطاء وزير التربية صلاحيات واسعة لمديري التربية في المحافظات لحل هذه الإشكالات. إلا أن هذا الإجراء حوّل مديريات التربية إلى مؤسسات متباينة بعضها عن بعض، سواء لناحية النظم المتبعة وحتى لناحية الرواتب التي لا تزال في مديرية تربية إدلب تساوي أكثر من خمسة أضعافها في مديريات التربية في مناطق سيطرة النظام السابق، وضعف الرواتب في مديرية التربية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السابق. هذا الأمر من شأنه أن يخلق إرباكاً كبيراً لدى تلك المديريات وموظفيها، خصوصاً في القضايا المتعلقة بانتقالات الموظفين بين المحافظات والعلاقات الإدارية فيما بينها.
كما أدى انتقال عدد من موظفي حكومة الإنقاذ في إدلب إلى دمشق وبعض المحافظات الأخرى إلى ظهور طبقة من الموظفين ضمن مؤسسات الدولة برواتب متباينة بعدة أضعاف عن رواتب أقرانهم في المؤسسات نفسها.
على المستوى الأمني، لا يزال هناك اختلاف واضح في التعاطي مع هذا الموضوع بين المحافظات، سواء لناحية التركيبة الأمنية أو لناحية تدخّل وزارة الدفاع في الموضوع الأمني في بعض المحافظات. ولا تزال وزارة الدفاع تتدخّل أمنياً في بعض المحافظات مثل اللاذقية وطرطوس، فيما يغلب الطابع الأمني على عناصر الأمن العام في باقي المحافظات مع اختلافات في تدخّل جهات أمنية أخرى لا تتبع لوزارة الداخلية مثل لجان شعبية تقوم بضبط الأمن مثل بعض مناطق ريف دمشق ومحافظة السويداء. هذا التباين في إدارة مختلف المناطق السورية من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى الإدارية ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جدية لإدارة كل المناطق السورية بالتساوي.
العربي الجديد
———————————
=========================
=======================
مقالات تناولت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لفرنسا
تحديث 13 أيار 2025
مقالات تناولت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لفرنسا تحديث 06 أيار
مقالات تناولت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لفرنسا تحديث 10 أيار
—————————–
الشرع يخطو إلى الأمام/ فاطمة ياسين
11 مايو 2025
يمكن اعتبار دخول الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا ضمن باب الحدث التاريخي لسورية الجديدة، ليس احتفاءً بالشرع ولا رغبة في تسجيل النقاط لصالحه، بل بوصفها أول زيارة لدولة غربية يقوم بها رئيس سوري منذ نحو 20 سنة… خيّم على سورية طغيان استمر أكثر من نصف قرن، حُرمت البلاد خلاله التواصل السليم مع دول العالم. واليوم يزور الرئيس السوري باريس بدعوة رسمية، وهي أول عاصمة أوروبية يتمكّن الشرع من الوصول إليها، حاملاً ماضياً يعرفه الجميع، يحاول أن يمسحه ويستعيض عنه بحاضرٍ من نوع آخر. وقد تكون هذه الزيارة بوّابته لهذا التأريخ الجديد. لذلك، لا أعتقد أنه جاء من باب المصادفة الاستعراض المصوّر الذي مهّد له فريق الشرع ببث فيديو قصير يَظهر فيه مع وزير الخارجية الشيباني وهما يلعبان كرة السلة في إحدى صالات القصر الجمهوري، مظهرين فرحاً “عفوياً” لحظة تسجيل الأهداف.
تأتي هذه الزيارة تحت العناوين التي أعلنها الشرع لنفسه حين أصبح رئيساً للبلاد، وقد ألزم بها نفسه للعبور نحو سورية مستقبلية لملاقاة لحظة حضارية فارقة، كان الشرع شاهداً على سلوك النظام الهارب وطريقة حكمه المشينة التي أودت بسورية إلى أخفض درك، ويعرف أيضاً أن التواصل مع الغرب بوابة ضرورية للنهوض بسورية، بحكم موقعها وإمكاناتها، وقد أوصل رسائل كثيرة بهذا الخصوص في كلماته التي ألقاها في مناسبات عديدة، أو من خلال سلوكيّاته التي يحاول فيها أن يظهر ذلك التقرّب. فمنذ اللحظة الأولى، وقبل أن يدخل دمشق، فُتحت السجون وأخرج كل المساجين، ومعظمهم كان موقوفاً لعلة سياسية، وكافح صناعة الحبوب المخدّرة، التي اكتشفنا أنها أضخم مما كنّا نتخيّل. فقد ضُبطت المصانع التي كانت في الملاحق السكنية لرؤوس النظام ومسؤوليه، وفي المزارع القريبة من العاصمة، والتي كانت تُدار جميعاً بمعرفة الفرقة الرابعة سيئة السمعة، ثم أوقف على الفور كل تعاون أو اتصال مع إيران وتوابعها. وقد حاولت إيران من طريق وسطاء أن تتقرّب من الشرع، لكنها وجدت طريقاً مغلقاً، وغير قابل للاختراق، فلجأت، على ما يبدو، إلى محاولات تشويش، وهي ليست بعيدة، في أي حال، عن حوادث الساحل المؤسفة وتأجيج مجاميع الفلول. ثلاثة من أهم البنود التي طالب بها الغرب نُفِّذَت على الفور، وهي وإن كانت مطلباً دولياً، فإنها أيضاً تصبّ في الصالح العام السوري، وقد انعكس أثرها الفوري على شكل انفراج اقتصادي، وإن بشكل بسيط.
كان وجه ماكرون باسماً، ورحّب بضيفه ووصفه بالقائد المناسب، وأعاد تكرار المطالبات عينها التي طالبت بها الإدارة الأميركية، واختتم كلامه بالنظر في عيني الشرع، قائلاً: أعتمد عليك! بوابة غربية مهمة مرّ الشرع منها، ويمكن البناء على هذه الخطوة، خطوات أخرى، خصوصاً وقد تلقى الشرع وعوداً بالعمل على رفع العقوبات عن سورية، وبعضها قد رُفع بالفعل، واستُثني بعضها الآخر، ما مكّن قطر من التكفل برواتب العاملين المدنيين في قطاعات الدولة، وهذا شريانٌ مهم يُكسب الدولة زخماً في العمل، ويعيد تزييت صوامل الحركة في السوق، بعد صدأ أصابها سنوات طويلة.
يعرف الشرع أن مهمته عسيرة، وأكبر تحدّ لها إرساء الأمن الذي يجب أن يتحقق قبل النهوض الفعلي بالاقتصاد، فلا بد من تخفيض مناسيب التوتر في كل المناطق، وإن كان الشرع قد نجح في الوصول إلى قلب الاتحاد الأوروبي، عبر إحدى أهم عواصمه، فهو يواجه تحدّياً لا يقل قساوة في الداخل، وهناك مجموعاتٌ ما زالت نشطة لا يناسبها جو الاستقرار، وبالقرب منه توجد إسرائيل التي اعترف الشرع بأنه يحاورها بكيفية غير مباشرة، محاولاً أن يأمن جانبها في الوقت الحالي، فهي طرفٌ خطيرٌ لا يمكن تجاوزه، ويجرّب الشرع أداة الحوار معها لإبقائها بعيدة عن المشهد الداخلي، والتفرّغ لإعادة الهدوء التام إلى الشوارع قبل إعادة البناء.
العربي الجديد
———————————
رسائل ماكرون لتركيا بحضور الشرع/ سمير صالحة
2025.05.11
حتى ولو تباعدت الرؤى التركية الفرنسية في التعامل مع العديد من الملفات الإقليمية فلا شيء يزعج أنقرة في أن يفتح الرئيس ماكرون أبواب قصر الإليزيه أمام نظيره الشرع وأن يدعو الغرب لتسريع خطوات رفع العقوبات عن سوريا الجديدة وأن تتبنى باريس دعم إبقاء سوريا موحدة متماسكة في وجه المشروع الإسرائيلي.
حرص الرئيس إيمانويل ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع، الذي يزور باريس في أول زيارة رسمية له إلى عاصمة أوروبية بدعوة فرنسية، على توجيه رسالة قوية، لم تخلُ من استعراض للقوة، وكان لتركيا، التي ترى فرنسا أنها تسعى للانفراد بالملف السوري، نصيبها منها. إذا كان الدعم الفرنسي لسوريا الجديدة هو لمصلحة كل السوريين فلم لن ترحب تركيا به حتى ولو أعلنت باريس أنها ستقف إلى جانب الشرع بانتظار تحول الأقوال إلى أفعال؟
يريد ماكرون إقناع دمشق بعدم الإصغاء لما تقوله وتريده أنقرة معولا على طموحات يريد تحقيقها: أن يقود الملف السوري باسم المجموعة الأوروبية، وأن تدعمه واشنطن في ملء الفراغ الذي سيحدث بعد إنسحاب القوات الأميركية من شرق الفرات ، وأن تسهل له تل أبيب مهمة تأمين الضمانات التي تريدها هناك من دون التصعيد العسكري والأمني الذي سيوتر الوضع أكثر فأكثر، وأن يحصل على دعم بعض العواصم العربية التي يقلقها تمدد النفوذ التركي في سوريا ويهمها لعب الورقة الفرنسية ضد أنقرة عند اللزوم.
بين أهداف ماكرون في سوريا وتحريك أوراق “قسد” وإسرائيل والدعم الأوروبي والتوغل في الملف اللبناني والحصول على بعض الدعم العربي لمواجهة النفوذ التركي نيابة عن الجميع. العقبة الأكبر هي مواقف ترمب وتصريحاته حول أن تركيا هي التي فازت في سوريا وإقناع واشنطن بتغيير مواقفها.
لماذا تنزعج أنقرة من حوار فرنسي سوري يرحب بدعم اتفاق “قسد” ودمشق وبضرورة تنفيذ بنوده؟ ومن موقف فرنسي رافض للممارسات والاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا؟ ويدعو لتسهيل رفع العقوبات الغربية عن السلطة الجديدة؟
لأن ماكرون يصر على إبقاء آلاف الدواعش في سجون “قسد” وتحت رعايتها وضرورة محاكمتهم حيث هم في سوريا والعراق، وعدم استردادهم. ولأنه يقول أن الانتقادات التي يوجهها البعض في الداخل الفرنسي بسبب حواره مع القيادة السورية في دمشق ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التمدد التركي في سوريا “لا تتعاونوا معهم ودعوهم تحت نفوذ الأتراك”.
ماكرون يرديد استرداد بعض ما فقدته فرنسا على خط الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب القوقاز لصالح اللاعب التركي في الأعوام الأخيرة وهذا من حقه. لكنه يريد من قيادة الشرع أن تسهل له المهمة وتعطيه ما يريد في سوريا تحت عنوان “الحوار المفيد والصارم”.
تريد فرنسا أن تعود لإنشاء خط الربط الاستراتيجي القديم بين لبنان وسوريا بعد تراجع نفوذها على أكثر من جبهة. وهي لا تريد التخلي عن ملف شرق المتوسط وخطط استخراج وتصدير الغاز ونسف التكتل السباعي الذي شيدته قبل 5 سنوات بدعم إسرائيلي يوناني. كما أنها تحمل أنقرة مسؤولية ذلك خصوصا في بلدان الاستعمار الأفريقي وجنوب القوقاز وخسارة الملف الأرمني هناك لصالح تركيا وروسيا.
وضع ماكرون على رأس لائحة المطالب التي يريدها من الشرع تسريع المرحلة الانتقالية وإنجاز وعود التغيير والإصلاح السياسي والدستوري والاجتماعي، لكنه لم يهمل “ضرورة طمأنة” إسرائيل، وتفعيل الحوار الإيجابي مع لبنان ومواصلة الحرب ضد حزب الله وداعش، والتعاون مع الشركاء الغربيين، والانفتاح على ” قسد “.
ذهب الشرع إلى فرنسا في محاولة لسحب ورقة “قسد” من يد الغرب، لكن ماكرون فاجأه بإعلان “عدم ترك الأكراد السوريين دون دعم فنحن مدينون لهم بالولاء”. أولويات باريس حسب التسلسل الفرنسي في سوريا هي تسهيل إعادة اللاجئين، تأخير انسحاب القوات الأميركية، رفع العقوبات بحسب الأفعال وعلى ضوء تقييم ما بعد 6 أشهر، وتأمين حماية مخيمات “داعش” في شرق الفرات ومحاكمة عناصره حيث هم في سوريا والعراق.
المشجع أكثر من غيره كان أن يسمع الشرع من ماكرون نفسه، أن فرنسا ستعمل على عدم تمديد العقوبات الغربية ضد سوريا، وأن ما تقوم به إسرائيل ممارسات سيئة، حيث لا يمكن حماية أمن بلد ما من خلال تعريض أمن بلد آخر للخطر خصوصا وأن الرئيس السوري أعلن بحضوره عن محادثات غير مباشرة تتم مع إسرائيل عبر وسطاء.
الفارق في المواقف وحجم التنسيق في التعامل مع السلطة السورية الجديدة واضح بين أنقرة وباريس منذ لحظة سقوط نظام بشار الأسد . فرنسا تقول على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو أنها لا تكتب شيكا على بياض وسترصد الأفعال وليس الأقوال . وتركيا سلمت الشيك لأحمد الشرع قبل أشهر طويلة على طريق إسقاط النظام وبناء الدولة السورية من جديد.
تواصل تركيا عرقلة التمدد الفرنسي في أكثر من بقعة جغرافية تباعدت المصالح والحسابات بشأنها . بالمقابل تعمل فرنسا على الحد من طموحات أنقرة الإقليمية، لكن في المشهد السوري لا يمكن لأنقرة تجاهل حقيقة بروز فرنسا كلاعب يقود الملف باسم المجموعة الأوروبية وهي التي بعثت بوزير خارجيتها جان نويل بارو، بصحبة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق لتهنئة الشرع بتوليه منصب الرئاسة ودعوته لزيارة باريس. وأن فرنسا قد تقود عملية التحول في المواقف السياسية الأوروبية حيال سوريا ومسألة رفع العقوبات عنها، إلى جانب ممارسة المزيد من الضغوطات الأوروبية على تل أبيب لوقف اعتداءاتها على سوريا. وأن ترتيب باريس للمؤتمر الدولي حول سوريا في منتصف شباط المنصرم كان مؤشرا سياسيا مهما باتجاه ترجمة هذه السياسات .
رغم التباينات الحادة بين السياسات التركية والفرنسية في سوريا، تلتقي مصالحهما في ملف تسهيل عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار مما يخفف أعباء البلدين الأمنية والمادية، ودعم انتقال سياسي يضمن الاستقرار تحت عنوان “سوريا موحدة”.
كما أن كلا الطرفين معنيان باستقرار شرق الفرات رغم الخلاف حول “قسد” ودورها، وفرص التنسيق المشترك في خطط وبرامج إعادة إعمار سوريا.
تملك تركيا الجار السوري الثقل الجغرافي واللوجستي ، وتملك فرنسا بالمقابل شركات ضخمة وشهية للمشاريع العملاقة . فهل تتحرك دمشق للاستفادة من هذا الثقل الوازن والدخول على خط التقريب بين باريس وأنقرة .
تتعامل تركيا مع دمشق كشريك مرن لا كحليف أيديولوجي، ودمشق أيضا تريد توظيف انفتاحها على أنقرة في الداخل والخارج وفق ضرورات ومتطلبات أمنية وسياسية واقتصادية واضحة. من الممكن تحويل ذلك إلى فرصة تقارب وشراكة للبلدين مع فرنسا نفسها على طريق التهدئة الإقليمية بين باريس وأنقرة بعد تراجع الدور والنفوذ الإيراني هناك.
تتقاطع مصالح تركيا وفرنسا في سوريا من باب الواقعية السياسية. تسجيل اختراق ثنائي في سوريا ، سيحمل فوائد استراتيجية للطرفين وللمنطقة، أهمها فتح الطريق أمام خفض التوتر داخل الناتو، وتقليص الفوضى، ومحاصرة النفوذ الإيراني والتصعيد الإسرائيلي، وضمان تحولات آمنة في سوريا.
تحولات المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشرع، إلى جانب تراجع النفوذ الإيراني، وانكماش الدور الروسي، وظهور إشارات انفتاح أميركي، قد تمنح دمشق هامشًا جديدًا للمناورة. حضور دمشق كحلقة وصل بينهما لم يعد مجرد تفصيل سياسي، بل احتمال استراتيجي قابل للتطور، وهذا قد يتيح لها فرصة لإعادة تموضعها كطرف عربي وإقليمي فاعل يحولها إلى جزء من الحل لا من المشكلة.
تلفزيون سوريا
————————————————
ما المطلوب من سوريا وما الذي تريده فرنسا؟/ د. مثنى عبدالله
حسنا فعل الرئيس الفرنسي إيميل ماكرون في دعوته الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا، وهي خطوة مهمة اتخذتها باريس تجاه السلطة السورية الجديدة، وسابقة متقدمة على الأوروبيين والأمريكيين معا. وكما هي العلاقات الدولية قائمة على المصالح واغتنام الفرص، فقد كان هم باريس التموضع بين بريطانيا وألمانيا، حيث الأولى لديها علاقات مهمة مع الحكم الجديد، قبل الوصول إلى السلطة، والثانية تسير مع الأتراك في خطواتهم في سوريا. وإذا كانت هذه الزيارة ليست مفاجئة، باعتبار أن الدعوة تم تقديمها للرئيس أحمد الشرع من قبل ماكرون في مؤتمر دعم سوريا في 13 فبراير/ شباط الماضي، فهي أيضا لم تكن من باب الصدفة. فالبدايات الفرنسية دائما شكلّت عبر التاريخ نقطة دخول لصالح سوريا إلى الساحة الأوروبية، ثم الانفتاح بين الطرفين الغربي والسوري على بعضهما بعضا.
ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء مع حدث اليوم، لوجدنا أن التاريخ يُعيد نفسه، حيث استقبل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد عام 2001 وتبعته أوروبا. لكن بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قطعت فرنسا علاقاتها بدمشق وتبعتها أوروبا، ثم عادت سوريا إلى الساحة الأوروبية عام 2008 عن طريق البوابة الفرنسية أيضا.
لا شك أن فرنسا في سعيها هذا لإعادة سوريا إلى المسرحين الأوروبي والأمريكي ليس عفويا، بل هي تسعى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، فعودة نفوذها إلى أية بقعة في العالم، جزء مهم من استراتيجيتها، التي تعززت اليوم بعد خروجها خالية الوفاض من الساحة الافريقية، وتوترت علاقاتها بشكل غير مسبوق مع الجزائر، وبالتالي لم يعد أمامها إلا التركيز على تعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها لا ترغب في أن يُترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلاعب وحيد في الساحة السورية، حيث ما زال التنافس بينهما قائما في هذه المنطقة، ومناطق أخرى من العالم. وقد لاحظنا كيف أنها نجحت في المساهمة في توقيع اتفاق بين حزب الله في لبنان وإسرائيل، واليوم هي تحاول أن تفتح الأفاق أمام النظام السياسي الجديد في سوريا، وتدفع الأوروبيين والأمريكيين للتواصل معه من خلالها، حيث لها قدم السبق في الانفتاح على النظام الجديد، فهي الأولى في زيارة دمشق بعد سقوط بشار الأسد، وهي الأولى في فتح سفارتها في دمشق، واليوم هي الأولى في استقبال الرئيس السوري في باريس. وهذا سوف يفتح البوابة الأوروبية في 27 دولة أمام سوريا الجديدة، غير أن هذه الزيارة لا تعني في أي حال من الأحوال، أن الفرنسيين سيمنحون الرئيس الشرع كل ما يُريد، وقد صرّح بذلك وزير الخارجية الفرنسي في تعليقه على الزيارة قائلا، (نحن لا نمنحه شيكا مفتوحا وسنحكم عليه بناء على أفعاله)، أي أن هناك مطالب غربية عليه أن ينفذها، وربما يمكن القول إن التقييم الغربي للنظام السوري الجديد سوف يعتمد على ثلاثة عناصر، ضمانة سوريّة على مكافحة الإفلات من العقاب، مشاركة كاملة في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، والحد من العنف الطائفي. وقد رد الرئيس الشرع على هذه المطالب قائلا، (أعتقلنا الخارجين عن القانون، وشكّلنا لجنتين الأولى للتحقيق في الحوادث، والثانية لإستعادة السلم الأهلي والتواصل مع المجتمعات المتضررة)، وأردف قائلا، (ناقشنا التعاون في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، مع تقييم مساهمة فرنسا في هذا الشأن). وكل هذه رسائل سورية مهمة لفرنسا وللاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أيضا، يؤكد فيها أن النظام الجديد في سوريا سيكون جزءاً من المنظومة الدولية، وسيلتزم بالقانون الدولي، وسيمتنع عن التدخل في شؤون الدول المجاورة. والأهم من كل ذلك هو ما يريده المجتمع الغربي، من أن سوريا ستكون جزءا فعالا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا.
ومع ذلك فإن الوضع في سوريا لا يمكن لفرنسا وحدها أن تأخذ فيه زمام المبادرة، فاللاعبون الدوليون والإقليميون كُثر، فهناك الولايات المتحدة وروسيا، وهناك إسرائيل وتركيا والسعودية وقطر والإمارات أيضا، وكل هؤلاء لديهم مصالح يريدون تحقيقها على الأرض السورية، وقد تتقاطع هذا المصالح، أو تتناسق، وما يهم الشعب السوري والسلطات الجديدة هو تحقيق مصالح سورية أولا، من خلال تنسيق الدعم في الشؤون الإنسانية، وتقديم العون الاقتصادي، وتخفيف بل رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري منذ النظام السابق. ويقينا أن الأولوية التي يبحث عنها الرئيس أحمد الشرع في فرنسا، هي أولوية سياسية وعسكرية وأمنية، لانه لا يمكن تحقيق الرخاء المجتمعي، من دون وجود قوة صلبة تعتمد عليها الدولة في بسط الأمن وتحقيق السلام، والضرب على أيدي الخارجين عن القانون، والتصدي للتهديدات الخارجية. ويمكن لفرنسا المساعدة في تحقيق ذلك، حيث لديها نفوذ قوي في المنطقة الشرقية من سوريا، سياسيا وعسكريا مع قوات «قسد»، وحتى اقتصاديا، من خلال شركاتها النفطية في هذه المنطقة، كذلك لفرنسا نفوذ تاريخي وعلاقات واتصالات مع الطائفة العلوية في سوريا، ويمكنها من خلال ذلك أن تساعد في استتباب الأمن في منطقة الساحل السوري، إضافة إلى إمكانية التأثير على إسرائيل، والوقوف موقفا فاعلا بالضد من العمليات الإسرائيلية جنوب غرب سوريا.
إن الطلب من النظام الجديد بسط سيطرته على كامل التراب السوري وهم كبير، لانه لا يملك الوسائل اللازمة للقيام بذلك، خاصة من ناحية تسليح الجيش السوري الجديد. فكل البنى التحتية العسكرية التي كانت قائمة في البلاد والأعتدة قد تم تدميرها مؤخرا من قبل إسرائيل، في حين توجد قوات «قسد» غير الحكومية بآلاف العناصر، ولديهم أحدث المعدات والعجلات العسكرية والعتاد على الأرض السورية. كما أن هناك فصائل مسلحة توجد في الجنوب السوري، تم تسليحها مؤخرا من قبل بعض القوى الخارجية، كل هذه القوات المسلحة خارج سيطرة الدولة، وكل هذا السلاح لا تحتكره الدولة، فكيف يُطلب من السيد الشرع ضبط الأمن والسلاح المنفلت؟ كما أن الحديث عن أن البوابة الفرنسية أو غيرها من النوافذ الخارجية، هي التي تعطي الشرعية للرئيس الشرع وحكومته، إنما تلك أضغاث أحلام، فالبوابة الوحيدة لكسب الشرعية والتي يمكن أن يعتمد عليها الشرع، هي البوابة الداخلية أولا، حيث يمنحه الشعب السوري الشرعية، التي تعززها العلاقات الدولية والتواصل الناجح مع العالم الخارجي. أما زياراته الخارجية فهي للسعي لإقناع الدول الغربية بأنه قد حان الوقت لرفع العقوبات عن شعبه، تلك التي فرضوها على النظام السابق، لكن أضرارها مست الشعب وليس النظام.
كاتب عراقي
القدس العربي
—————————-
بعد زيارة الشرع… ما الذي يُحفّز الانفتاح الفرنسي على الإدارة السورية الجديدة؟/ عمار جلّو
الثلاثاء 13 مايو 22025
“أخبرت الرئيس بأنه إذا استمرّ في طريقه، فسنفعل الشيء نفسه، وبالتحديد من خلال الرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذوهم في هذا الشأن”، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع.
أضاف ماكرون: “العقوبات عقبة ناقشناها باستفاضة. شرحت كل العواقب والآثار وقلت إن العقوبات فُرضت على النظام السابق ولا شيء يبرر الحفاظ عليها”، مشيراً إلى أنه سيقترح لاحقاً السماح بإنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبي في الأول من حزيران/ يونيو القادم. وفي المقابل، يجب على الشرع فعل “كل شيء لضمان حماية جميع السوريين دون استثناء”، تابع ماكرون.
وتمثّل الزيارة التي قام بها الشرع إلى باريس، في السابع من الشهر الجاري، بناءً على دعوة تلقّاها من نظيره الفرنسي، دفعةً دبلوماسيةً مشروطةً له من قوة غربية، حسب موقع “عرب ويكلي”، بعد إعلان واشنطن عدم اعترافها بأي كيان كحكومة سورية.
دوافع الدعوة وتلبيتها؟
على الصعيد السياسي، يسعى الشرع، إلى تعزيز الشرعية والاعتراف الخارجي بإدارته، بما يتخطى حدود الجوار السوري العربي والإقليمي، بجانب تطوير علاقات دمشق الخارجية، لاستعادة مكانتها الدولية، حسب مركز “شاف للدراسات المستقبلية”. وعليه، فإنّ استقباله في باريس، قد يؤدي إلى عودة دمشق إلى الجماعة الدولية من البوابة الفرنسية.
إلى ذلك، يشير موقع “abcnews”، إلى وقوع الزيارة تحت مجهر المراقبة عن كثب، كونها اختباراً محتملاً لاستعداد أوروبا للانخراط مع القيادة السورية الجديدة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فيأمل الشرع، في الحصول على دعم باريس في ملف رفع العقوبات الغربية على سوريا، وهو ما ظهرت مؤشراته الإيجابية عبر تعهّد ماكرون، بالضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على دمشق، بجانب دعوته واشنطن لإنهاء عقوباتها على دمشق سريعاً.
كما يأمل على الصعيد الأمني، في بناء حشد دولي ضد الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، وهو ما تحقق أيضاً، عبر التنديد المباشر والمشترك من قبل الرئيسَين بانتهاكات تل أبيب لسيادة الدولة السورية.
في المقابل، وعبر استقبال الشرع، تخدم باريس عدداً من مصالحها الأمنية، مع معالجة بعض التحديات الأوروبية، ومنها مكافحة خطر تنظيم داعش الإرهابي، بجانب مكافحة تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية، وضبط الحدود السورية اللبنانية، والانعكاسات الأمنية والسياسية التي قد يشهدها لبنان على خلفية ما يحدث في سوريا.
سياسياً، تحاول فرنسا كسب زخم دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، والاحتفاظ ببعض أوراق النفوذ فيها، عبر لعب دور فاعل في سوريا ولبنان، بجانب اكتساب نفوذ عبر لعب دور الوسيط بين الأكراد ودمشق.
اقتصادياً، تسعى فرنسا إلى تحصيل بعض الامتيازات والمكاسب الاقتصادية، ولا سيّما في ملف إعادة الإعمار والاستثمارات الأجنبية في سوريا.
من حيث الشكل، تُعّد الزيارة خطوةً مهمةً نحو إعادة إدماج سورية في المجتمع الدولي، وبوابته التقليدية فرنسا، حسب المستشار السابق لرئاسة الجمهورية السورية والكاتب والباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الدكتور جمال السيد أحمد.
أما من حيث المضمون، فتشكّل الزيارة قطعاً مع توجهات السياسة الخارجية السابقة، حيث التوجه إلى الغرب والتأمل في تغيير التحالفات، بل قلبها، ديدن التوجه الجديد، وهو ما يلقى صدى لدى الدول الغربية، من خلال مفتاح واحد وأساسي، هو توجه النظام السوري الجديد نحو طمانة إسرائيل بالأمن والسلام بأثمان غير معروفة لغاية الآن.
وخلال حديثه إلى رصيف22، يشير السيد أحمد، إلى “مساعي فرنسا للعب دور أساسي في سوريا الجديدة، وتمتين وجودها وأقدامها فيها بالاستناد إلى إرث النفوذ القديم وأحلام الدولة الكبرى ذات الدور الذي كاد أن يتبدد. وفي المقابل، لدى الشرع رغبة في الحصول على دعم دولي لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء سوريا المدمّرة”، منبّهاً إلى أنّ “الزيارات الخارجية مع أهميتها، يجب ألا تكون على حساب الداخل السوري، الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر بحاجاته ومتطلباته ومشكلاته، وذلك لكيلا يكون عبئاً على السياسة الخارجية، أو محلاً لاشتراطات الخارج”.
يؤيد ذلك إلى حدّ ما الباحث في معهد الشرق الأوسط، الدكتور سمير تقي، الذي يعدّ الزيارة مفيدةً في توضيح متطلبات المجتمع الدولي ونوايا الحكومة السورية، ولإيجاد آلية يساعد من خلالها المجتمع الدولي حكومة دمشق لتتمكن من الاستجابة للشروط المطلوبة منها دولياً، مشيراً إلى أنها تشكل مدخلاً لاكتساب الاعتراف الدولي بحكومة الشرع.
لكن المشكلة تكمن في طبيعة الشروط التي يضعها المجتمع الدولي، سواء للاعتراف بالحكومة الجديدة أو لرفع العقوبات عن سوريا، وهي شروط لا تحظى بالإجماع لدى هذه الدول. والواضح لديه، هو وجود توجه إلى أن تكون المملكة العربية السعودية وسيطاً رئيسياً يلعب دور الحاضن للتجربة السورية، يضيف.
وعليه، يعتقد تقي، خلال حديثه إلى رصيف22، أنّ “المسألة تتعلق بالعلاقة مع فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى بتطوير العلاقات والتحالف الإستراتيجي مع رؤية الرياض لمستقبل المنطقة”، وهذا بجانب اعتقاده بـ”وجود تفاعل بين المصالح الأوروبية ومصالح دول الخليج التي لها رؤيتها الخاصة لمستقبل سوريا، بالإضافة إلى الارتباط بمسألة العلاقة مع واشنطن، التي لا تزال تضبط خطواتها تجاه سوريا بإيقاع علاقتها مع الرياض والعواصم الأوروبية”.
ويستطرد: “لا شك في أن الزيارة ستساهم في زيادة الضغط السياسي من أجل رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا، على الرغم من الاعتبارات التي تتخذها السلطات الأمريكية والأوروبية التي لا تزال تميل إلى إبقاء سوريا تحت المراقبة، وعدم إطلاق عملية كاملة للتعافي وإعادة البناء، طالما أنّ الشروط التي تضعها لم تنفّذ”.
الاقتصاد حليب السياسة
تأسيساً على ما سبق، لعبت باريس دوراً محورياً في محاولة تحفيز المجتمع الدولي لدعم الإدارة السورية الجديدة، حسب مركز “إنتريجونال للتحليلات المستقبلية”، وذلك عبر استضافتها “مؤتمر دعم سوريا” في شباط/ فبراير الماضي، وخلاله تم التأكيد على أهمية دعم الانتقال السياسي، ورفع العقوبات، وتقديم الدعم الإنساني، مع التزام الدول العشرين المشارِكة في المؤتمر بتعزيز التعاون الأمني لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، بجانب مشاركتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في إعداد ورقة “إعادة التفكير في سياسة العقوبات على سوريا”، التي تم تقديمها للاتحاد في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتشكل زيارة الشرع، إلى باريس، إشارةً دوليةً قويةً على وجود نظام سياسي جديد في سوريا، بجانب اعتبارها فرصةً لاختبار نوايا حكومة دمشق الوليدة ومدى قابليتها للانخراط مع المنظومة الدولية، حسب غسان جمعة، وهو باحث ماجستير في القانون الدولي العام ورئيس تحرير صحيفة “حبر” السورية. لكن لا يمكن اعتبارها اعترافاً دولياً أو مدخلاً لهذا الاعتراف، بقدر ما هي سبر للنوايا وتشارك للأفكار حول المواضيع الاقليمية مع الوضع السياسي السوري.
“من المهم لفرنسا، وللدول الأوروبية والغربية عموماً، سماع وجهة نظر الرئيس الشرع حول ملفات الانتقال السياسي والحريات، بجانب الملفات الإقليمية، مثل الملف اللبناني والملف الإسرائيلي”، يضيف جمعة، في حديثه إلى رصيف22.
وكانت باريس قد عززت علاقاتها مع السلطات السورية الانتقالية، حسب شاف، وعيّنت قائماً بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين كخطوة نحو إعادة فتح سفارتها بالكامل، وحصدت أول مكاسبها الاقتصادية، من خلال توقيع شركة “CMA CGM” الفرنسية، في شباط/ فبراير الماضي، عقداً مع الحكومة السورية مدته 30 عاماً، بقيمة 230 مليون يورو، لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية.
في سياق متّصل، يرجّح المجلس الأطلسي دمج سوريا في تجارة الغاز الطبيعي الإقليمية مستقبلاً، وأنها قد تصبح دولة عبور للغاز الإسرائيلي والمصري المتجه إلى تركيا وأوروبا. على ذلك، ستتمتع الشركات الأجنبية مثل “توتال” و”شل”، اللتين عملتا في سوريا خلال حقبة الصراع، بميزة الوصول إلى الاستكشاف والإنتاج السوري.
وتُعدّ الشركة الفرنسية “توتال” مثالاً واقعياً لما يسمّى بـ”دبلوماسية الشركات”، حسب موقع “الناشر”، كما تُعدّ في طليعة الوجود الفرنسي في المنطقة، وقد خلقت تواصلاً وترابطاً، اقتصادياً وثقافياً وسياسياً، متعددَي الأوجه، لتصبح قائد كونسورتيوم النفط الدولي الجديد منذ خمسينيات القرن الماضي. وتهدف إلى حماية مصالحها الخاصة، عبر اعتماد دبلوماسية بعيدة عن الهامش الرسمي الحكومي، إلا أنّ مرجع قرارها مرتبط بقوى الدولة العميقة المتحكمة في مفاصل السياسات الاقتصادية العالمية، والتي تعدّ الشركة أداةً من أدواتها.
مع ذلك، يكمن إشكال “توتال” الخاص في كيفية إدارة المزاج الأمريكي المتقلب، والذي قد يضرب مصالحها في المنطقة.
يضيف الموقع: “أثبت التاريخ أنه مع صمت المدافع، تدخل الشركات الكبرى تحت راية البناء والتنقيب والبحث عن الثروات، مزوّدةً بالخبرات والخطط والتقنيات العالية لإعادة رسم الخرائط الجيو-سياسية. وفي ما يخصّ توتال تحديداً، تقوم إستراتيجيتها الإقليمية على حصد أكبر عدد ممكن من العقود في منطقة ترتفع فيها تكاليف الإنتاج بسبب التنافسية الشديدة”.
في هذا السياق، يشار إلى “مساهمة فرنسية واضحة في الوساطة الأمريكية” في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سابقاً. وعليه، حصلت “توتال” على رخصة إنتاج الغاز من حقل “قانا”، فيما ستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته مستقبلاً، كما أبرمت “توتال” اتفاقاً مع الحكومة العراقية لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بتكلفة قدرها 27 مليار دولار.
“لدى فرنسا طموحات اقتصادية واضحة في سوريا”، حسب بنجامين فيف، وهو باحث أول في شركة “كرم شعار للاستشارات”، وهي شركة استشارية مسجلة في نيوزيلندا، وتركز على الاقتصاد السوري وعلاقته بالسياسة. وقد بدأت هذه الطموحات تظهر من خلال تفعيل استثمارات شركة “CMA CGM”، منبّهاً إلى وجود شركات فرنسية أخرى بجانب “توتال” مهتمة بالساحة السورية، لكن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على حقول النفط تعقّد المشهد أمامها.
إلى ذلك، تصعّب العقوبات الغربية تنفيذ هذه الطموحات فعلياً، برغم انفتاح الشرع وترحيب ماكرون، حسب فيف، الذي يشير إلى أن فرنسا قد تسعى عبر انخراطها الاقتصادي في سوريا إلى استعادة نفوذها وتقليص تأثير تركيا وروسيا على دمشق. هذا بجانب هدفها الأساسي بإعادة ترسيخ حضورها في المنطقة وتعزيز مكانتها الإقليمية. “تاريخياً، كانت فرنسا حليفاً رئيسياً لسوريا قبل 2011، وتسعى اليوم لاستعادة هذا الدور”، يضيف فيف، لرصيف22.
موازنة تحركات القوى المنافسة
سابقاً، أعلنت تركيا عن نيتها بدء مفاوضات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا، ما يرجح إثارة معارضة من قبرص واليونان، اللتين قد تلجأن إلى واشنطن وبروكسل للحصول على الدعم، حسب المجلس الأطلسي.
وتحاول باريس موازنة التحركات التركية في سوريا، حيث يكشف استقبال ماكرون للشرع، عن اهتمام باريس المتزايد بموازنة تحركات القوى المنافسة في سوريا، وفي مقدمتها تركيا. وهذا الاهتمام برز بشكل واضح عقب ضغوط أنقرة على باريس لاستعادة مقاتليها المنتمين إلى “داعش”، بداية العام الحالي، وهو ما يعكس توتراً كامناً بين الدولتين على الساحة السورية، حسب “إنتريجونال”، حيث تبدو باريس قلقةً من احتمال تهميش حضورها في منطقة تمثل إحدى نقاط الارتكاز المهمة لها لمصلحة تركيا، وهو ما يفسر استضافتها مؤتمر دعم سوريا والقمة المصغرة حول سوريا في آذار/ مارس الفائت، بمشاركة اليونان وقبرص ولبنان وسوريا.
تضاؤل نفوذ إيران في سوريا، حرّك قوى إقليمية أخرى، ومنها أنقرة وتل أبيب، لفرض واقع جديد يناسب رؤيتهما الأمنية والسياسية الإقليمية المتناقضة، ما يعكس بداية تنافس عميق، وهي تحولات غير مؤكدة وخطيرة أحياناً، حسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ecfr)، إلا أنها تقدّم لأوروبا فرصةً للمساعدة في تشكيل نظام إقليمي أكثر استقراراً.
للقيام بذلك، يتعيّن على الحكومات الأوروبية تكثيف جهودها لمواجهة محرّكين رئيسيين للفوضى؛ التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، وسوء الحكم الذي ترك سوريا تتأرجح على حافة الهاوية. ومع إظهار حكومة دمشق انفتاحاً حذراً على الإصلاح، يمكن للدعم الأوروبي أن يعزز هذا المسار الإيجابي، بما يقلل من اعتمادها على طموح
رصيف 22
———————————
=========================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 13 ايار 2025
عن أشتباكات صحنايا وجرمانا تحديث 13 أيار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
—————————–
هل علينا أن نحذر من الحرب الأهلية؟/ حسام جزماتي
2025.05.12
رفض معظم السوريين وصف ما جرى في وطنهم، خلال السنوات اللاهبة الماضية، بأنه «حرب أهلية». عبّر جمهور الثورة عن هذا في مناسبات عدة، كما صرّح بذلك النظام ومؤيدوه حين كانوا يزعمون أن الاحتجاج عليه مؤامرة خارجية لا مطالب داخلية من أهل البلد.
ولم تأت هذه الحساسية من فراغ. فهناك فارق كبير بين أن تكون ثائراً ضد الظلم والطغيان والاستئثار، سلماً أو حرباً، وبين أن تكون «أحد أطراف النزاع» في صراع محلي. وكذلك بين أن تكون ذراع «الدولة» التي زعمت احتكار الشرعية والدفاع عن وحدة البلاد وأمان العباد، وبين أن تكون عنصراً في قوات عسكرية مدججة مهمتها حماية عرش الأسد واستثمار بعض الشعب ضد بعضه الآخر.
انقضى كل ذلك حين هرب الرأس تاركاً النظام تحت وطأة تكسّر مفاجئ، وقواعده البشرية قيد الذهول، وخصومَه المنهكين في خضم فرح غامر أدار رؤوسهم على غير توقع. وإثر الانتصار السهل، وكلفته البشرية القليلة نسبياً بالقياس إلى المخاوف؛ ساد بين السوريين تفاؤل جارف بمستقبل واعد لبلاد محررة ومزدهرة. لم يتوقع أحد أن المسار سيكون يسيراً معبّداً لكن الجميع ظنوا، أو أمِلوا، أن صفحة «الحرب» قد طويت، وأن الباقي مصاعب هائلة لكنها اقتصادية وإعمارية وخدمية وإدارية وسياسية. ولكن ذلك بدا «مقدوراً عليه» طالما أننا «بالحب بدنا نعمّرها».
قد لا يكون الحب شرطاً لازماً لبناء البلدان، أو استعادة عافيتها، لكن حداً أدنى منه لازم لضمان السلم الضروري لأي تحرك. فضلاً عن أن الكره ليس شعوراً فحسب، بل أرضاً خصبة لقيام «حرب أهلية» موصوفة. واليوم، بعد خمسة أشهر على التحرير، نلاحظ شكاً في موجة التفاؤل التي رافقته، بل تراجعاً كبيراً عنها في بعض البيئات.
في الحقيقة لم يكن بشار الأسد عنواناً لمعسكره من الرافضين للثورة فقط، بل رمزاً للتغيير الذي ينشده آخرون وضعوا الإطاحة به في أول مطالبهم. وبهذا المعنى كان وجوده علامة على أن النزاع سياسي مهما خالطته عصبيات أهلية لطالما استند إليها نظام الأسدين، وتكاتفٍ مضاد استقر تدريجياً على أوساط أغلبية من السنّة العرب. ولذلك كسرت الإطاحة به الأسوار السياسية، الآيلة للسقوط وشبه المزيفة، للصراع الذي بدأ يسلك السبيل الأسهل لوجوده، وهو الطائفية السافرة.
ليس مستغرباً أن تبدأ معالم التشقق بالظهور على الحدود العلوية. فللطائفة دور مركزي في دعم الأسد، وإن لم يكن وحيداً، وبينها أعداد أكبر من المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وهم مطلوبون للمحاكم في حال استوى أمر العدالة الانتقالية المنشودة، أو معرّضون، بشكل عشوائي يخلطهم بغيرهم من المدنيين، لأعمال انتقامية لا تتبين فيها حدود العدل عن الثأر الجماعي. لم يحدث هذا في مطلع آذار المنصرم فقط، بمجازر معروفة، بل قبل ذلك وبعده في حوادث بالمفرّق سوى ما تكثف جملة.
ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن «الحوادث الفردية» لم تطل العلويين فقط، والمرشديين الذين يمازجونهم في الجغرافيا والأصول، بل حصلت في معظم الأراضي السورية وفي بيئات السنّة أنفسهم. فحين عاد الثوار إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، فاتحين، أطلقت الصدور المنتشية سراح ثارات معتقة حبيسة تجاه من كانوا أعوان النظام، بقواته النظامية أو الرديفة (الدفاع الوطني وسواه) أو المخبرين (العواينية). وفي ذاكرة الأرياف، وحارات المدن، سجلٌ لكل من كان مسؤولاً عن اعتقال ثوار عادوا أو بلعتهم الأجهزة الأمنية والسجون، وحساب طويل على التجبر والإهانات والابتزاز والاستيلاء على المنازل والأراضي. ورغم أن هذا ليس مشتهراً على نطاق واسع فإن أعمال القتل المحلي أو الملاحقة أو الوعيد الصريح حدثت بوفرة في حواضن الثورة.
وإذا كان كل ما سبق قد جرى تفهمه، أو فهمه، في سياق غليان الغضب في عروق «أولياء الدم» كما يسمّون، من الناجين أو من ذوي الضحايا خلال الثورة، فإن انتقال الزمجرة الدامية لتهديد بيئات أخرى صار يطرح سؤالاً عن الكراهية مؤخراً. فمن المعروف أن تسجيلاً صوتياً مجهولاً أساء إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، فجّر أحداثاً أوسع تجاه الدروز في جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء، وحتى في حق طلاب جامعيين. وقد سبق لطائفة الموحدين أن ابتعدت، إلى حد غالب، عن المشاركة في «الصراع السوري» قبل سنوات، والتزمت، قدر ما تستطيع، بعدم التحاق أبنائها بالخدمة الإلزامية ما عدا بعض الحالات والشرائح الموالية منها.
وإذا كان العقلاء في الدين، وعلى رأسهم المفتي أسامة الرفاعي، والسياسة، ومنهم ممثلو السلطة الحالية، قد اتفقوا على الضبط والتهدئة؛ فإن أنياب «الفصائل غير المنضبطة» على الأرض وفي المجال العام، أثبتت أن الضواري تتعطش بقوة لنهش جسد الآخر، بعد تكفيره دينياً وتخوينه وطنياً بتعميم توجهات معينة على الجميع، والبحث عن العدو لا الصديق. وقالت هذه الأحداث إن متاريس العقل هشة وإنها تهتز بعنف على أياد كثيرة مضرجة بالدم.
ولا يخفى أن جمهور الكارهين هذا يهمُر بالاتجاه الشمالي الشرقي، ملوحاً للكرد بأن ما يحول بينهم وبين التعرض لسيوفه وفؤوسه هو الاتفاقات التي جرى توقيعها والتي يُنتظر تنفيذها، وفق تفسيرات لم تتضح معالمها، على يد لجان ربما لا تصل إلى نتائج تشبع شهوات سطوة جمهور يرى نفسه في صف موحد حتى الآن.
وبالانطلاق من النقطة الأخيرة فإن شعور الاتحاد متماسك فقط في مواجهة آخر. أما حين يسترخي أهل الدار فلا ضمانة ألا تستيقظ خلافات البيت الواحد، الفصائلية والعشائرية والمناطقية، فتكون الساطور الذي يقصم ظهر البلد.
ولذلك، لا إمام سوى العقل مهما بدا هذا الكلام هرماً. ومهما قيل إنه تنظير لا يلبي غرائز جيل لم يعرف غير الحرب، التي لم تكن أهلية.
تلفزيون سوريا
————————————–
إسرائيل وسوريا بعد سقوط الأسد: من التصعيد إلى اختبار التفاهمات
11 مايو 2025
يقدّم معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحليلًا معمقًا لتحولات المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، مركّزًا على فرص التقارب والمخاطر من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي. ويرى أن السياسات الجديدة للرئيس السوري أحمد الشرع تفتح الباب لتفاهمات إقليمية، لكنها تصطدم بتحديات داخلية، يبرز في مقدمتها هشاشة الوضع الأمني.
يفتتح معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مقاله التحليلي بالإشارة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 لحظة مفصلية في تاريخ سوريا، وأدى إلى تغيّر جذري في موازين القوى. وأضاف أنه من بين احتمالات “الاعتدال والحكم الشامل” أو “انعدام الاستقرار المُغذّى بالتطرف”، تبقى الشكوك قائمة حول “النيات الحقيقية للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع”.
وأشار المعهد إلى أنه رغم الجدل، رسّخت الحكومة السورية الجديدة سلطتها بسرعة وشكّلت حكومة انتقالية خلال أربعة أشهر، وبدأت بإرسال “رسائل تهدئة إلى العالم والدول المجاورة، وبصورة خاصة إلى إسرائيل”، معلنة جدول أعمال يركّز على “تقاسُم السلطة، ومنح الحقوق للأقليات، والتنمية الاقتصادية”.
ولفت المعهد إلى أن السلطات السورية تواجه تحديات في فرض سيطرتها الكاملة، معيدًا التذكير بأحداث العنف الدامية التي استهدفت الطائفة العلوية في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، الأمر الذي دفع بالشرع إلى إدانة العنف وتشكيل لجنة تحقيق وطنية. كما ذكّر بأحداث العنف التي شهدها جنوب دمشق، واستهدفت المدنيين الدروز نهاية نيسان/أبريل الماضي، ما كشف عن “سيطرة الشرع الجزئية على الجغرافيا”.
ووفقًا للمعهد، رغم سياسة الشرع التي فتحت بابًا لإعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، تبنّت إسرائيل نهجًا تصادميًا مدفوعًا بـ”صدمة السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، وصرّحت بأن الحكومة السورية الجديدة يقودها “إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة”، الأمر الذي يعتبره المعهد “يثير تساؤلات عن مدى استعداد إسرائيل لإعادة النظر في علاقتها مع سوريا”.
ومن جديد، يُعيد المعهد التذكير بإعلان إسرائيل سياسة “حماية الأقليات”، بتركيزها على دعم “الأكراد والدروز”، فضلًا عن استخدامها “الوسائل العسكرية” لحمايتهم. ويرى المعهد هنا، أن هذه السياسة جعلت من إسرائيل طرفًا فاعلًا في الصراع الداخلي السوري، وأكدت تموضعها في موقع “معارض للحكومة التي تقودها الأغلبية السُّنية”، ما يزيد من تعقيد التوازنات في الجنوب السوري.
ويشير المعهد إلى أن إسرائيل تسعى لمنع الفراغ الأمني، لكن “الحكام الجدد في دمشق ليسوا حماس”. فقد طردت الحكومة السورية “حماس” و”الجبهة الشعبية”، واعتقلت قياديَّين من “الجهاد الإسلامي”، كما “بذلت جهودًا كبيرة لإحباط محاولات حزب الله تهريب الأسلحة”، بما في ذلك استهداف قواته على الحدود السورية – اللبنانية.
وبحسب المعهد، رغم التزام الشرع العلني باتفاق وقف إطلاق النار وتجنّب الصدام، فإن إسرائيل واصلت تنفيذ غارات جوية داخل سوريا، أبرزها “الضربة غير المألوفة بالقرب من القصر الرئاسي”، فضلًا عن مقتل تسعة أشخاص جراء غارة استهدفت جنوب سوريا، ما أثار احتجاجات شعبية ودعوات للتسلّح. ويرى المعهد أن هذه الهجمات قد تُغذي “المقاومة ضدها” وتُفاقم احتمالات المواجهة.
ويشير المعهد الإسرائيلي إلى أنه منذ سقوط الأسد، سعت إيران لتوسيع نفوذها عبر “تسليح جماعات وكيلة”، منها “العلويون، وحزب الله، وميليشيات عراقية، ومسلحين أكراد”. وعلى الرغم من انسحابها من بعض المناطق، استمرّ دورها التخريبي. المفارقة أن “سياسة إسرائيل قد تساهم في دعم السردية الإيرانية”، عندما اتهمت الحكومة السورية بارتكاب المجازر في الساحل، رغم أن ” الواقع على الأرض كان أكثر تعقيدًا وتفصيلًا”.
ونوه المعهد إلى مساعي تركيا لتوسيع نفوذها في سوريا بعد سقوط الأسد، عبر مفاوضات دفاعية مع دمشق ونشر دفاعات جوية في قاعدة T4، ما أثار قلق إسرائيل التي كثّفت غاراتها الجوية. ورغم تردد الشرع في الانحياز الكامل لأنقرة، فإن التصعيد الإسرائيلي قد يدفعه نحو التحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا للمركز، يساهم تركيز إسرائيل على الغارات الجوية وحماية الأقليات في تقويض الحكومة المركزية، ما يعزز الانقسام الذي تستغله إيران لإعادة نفوذها عبر “حلفائها السابقين وشبكات وكلائها”. وفي ظل هذا التنافس، تصبح سوريا المنقسمة بيئة خصبة “لازدهار داعش والقاعدة وحماس”، التي تعمل السلطات الجديدة على “قمعها” حاليًا.
كما تُناقض سياسة إسرائيل في سوريا مبدأها المشترك مع واشنطن، الداعي إلى دعم الحكومات المركزية لمواجهة النفوذ الإيراني. ففي حين تسعى لتقوية الدولة في لبنان والعراق، تعمل في سوريا على “تقويض الحكم المركزي”، ما يمنح إيران فرصة لاستغلال الفوضى عبر وكلائها، كما تفعل في دول أخرى، وفقًا لتحليل المعهد.
قد تمنح الدولة المنقسمة إسرائيل حرية حركة أكبر، كما يرى المعهد، لكنها ستواجه “تعدّد التهديدات”، ما يستنزف مواردها ويزيد خطر التورط في صراع جديد. وفي المقابل، يمكن لإسرائيل أن تستفيد من نجاحاتها الأخيرة ضد إيران و”حماس” بتبنّي “استراتيجية بنّاءة” بدل تعميق الفوضى في سوريا.
وعلى الرغم من الغموض المحيط بمستقبل سوريا، فإن المصلحة الإسرائيلية تقتضي خطوات استباقية، تبدأ بـ”بلورة تفاهمات” أمنية مع الحكومة الجديدة، وتفتح المجال لاحقًا لتعاون أوسع، وفقًا للمقال ذاته.
أما على مستوى تركيا، يعتبر المعهد أنه من المثير التفكير في إمكانية تحوّل دمشق من “محور صراع” إلى ساحة تعاون تركي-إسرائيلي، خاصة مع تقاطع المخاوف الأمنية من النفوذ الإيراني. ويمكن لهذا التعاون أن يشمل “قيودًا على نشر أنظمة الدفاع الجوي التركية” في سوريا، ما يفتح المجال لحوار حول استقرار البلاد ومكافحة التطرّف.
كما يمكن لإطار تفاهُم مشترك، مدعوم من واشنطن ومنسق مع أنقرة، أن يوفّر مزيجًا من الردع والدبلوماسية، ويُمهّد لـ”انسحاب إسرائيلي حذر وآمن”، مقابل صعود سلطة سورية مسؤولة. وفي حال اتخذت دمشق خطوات إيجابية، قد تُقابلها إسرائيل بـ”إشارات متبادلة حذِرة” تمهّد لمسار سياسي جديد.
ويشير المعهد إلى أن مصالح إسرائيل تتقاطع مع مصالح دول المنطقة، بما في ذلك الأردن ومصر والخليج في استقرار سوريا، والحد من التطرف الإسلامي والنفوذين الإيراني والتركي. كما يمكن لإسرائيل، بالتنسيق مع دول الخليج، أن تدفع “بمشاريع بنية تحتية مشتركة”، خاصة في “المياه والزراعة”، ما يعزز تعافي سوريا ويكرّس إسرائيل “لاعبًا إقليميًا بنّاءً” يخدم مصالح المنطقة، وفق تعبيره.
يخلص المعهد في هذا المقال التحليلي إلى أنه على المدى البعيد، قد تخدم “سوريا موحّدة، أقل اعتمادًا على إيران، ومحالفة للدول العربية المعتدلة” المصالح الأمنية الإسرائيلية بشكل أفضل، خاصة إذا اعتمدت نموذجًا لتقاسم السلطة. كما أعاد التذكير بإشارة الرئيس الشرع لعضو الكونغرس كوري ميلز إلى استعداد بلاده للانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام، في ظل الشروط المناسبة”.
ويختتم المعهد تحليله بالتأكيد على أنه يُفترض أن يكون الانخراط الإسرائيلي والدولي مشروطًا بـ”التزامات واضحة”، تشمل إضعاف النفوذ الإيراني، تفكيك القدرات الكيميائية، وضمان حقوق الأقليات. ويمكن أن يُمهّد بناء الثقة نحو تطبيع تدريجي يبدأ بـ”اتفاقيات أمنية وتعاون مشترك”، ما يساهم في تقليص خطر التطرف وتعزيز الاستقرار في الإقليم.
الترا سوريا
——————————–
من التوتر الطائفي إلى التدخل الإسرائيلي.. قراءة في أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء
نشر في 10 أيار/مايو ,2025
أواخر نيسان/ أبريل 2025، هاجمت مجموعات مسلّحة مناطق عدة يقطنها سوريون دروز، في جرمانا وأشرفية صحنايا وقرى السويداء الغربية. وكانت الهجمات مفاجئة ودموية، وجرت بوتيرة متصاعدة من دون أي مبرر واضح، وقد بدت -في ضوء سياقها وتوقيتها وأدواتها- وكأنها مدبّرة سلفًا، بهدف صبّ الزيت على نار التوتر الطائفي، لا سيما أنها استندت إلى تسجيل صوتي مفبرك سرعان ما تبيّنَ زيفه، وبالرغم من صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية يؤكد أن ذلك المقطع مزوّر، فقد حدثت تظاهرات في عدة مدن، ثم تصاعد الموقف بعد ذلك. وتطرح هذه الأحداث تساؤلات عن هوية الجهات الفاعلة أو المستفيدة من تفجير هذا الوضع الأمني والاجتماعي، وعن دوافع هذا التصعيد، ولا سيّما مع غياب ما يُفسّر انفجار العنف بهذا الشكل.
وقد أدّت تلك الأحداث إلى مقتل وجرح العشرات، وعلى الرغم من قيام قوات الأمن العام بجهود لمنع الهجمات، فقد استمرت حالة التوتر عدة أيام، تلتها مساع من الحكومة بدمشق لعقد اتفاقٍ يقضي بامتداد سلطة الدولة إلى مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا، وهي مناطق يقطنها سوريون من المكوّن الدرزي، ولكن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه صعوبات تحول دون تنفيذه التام، وما يزال الوضع يشهد حالة من التوتر والترقب.
تزامنت تلك الأحداث مع مناخ من التوتر المجتمعي الحاد، وهذا ما يعزز الحاجة إلى إجراء قراءة معمقة في مسار هذه الأحداث ودلالاتها، حيث لا يمكن فهم التصعيد الأخير بمعزل عن المناخ العام المتوتر الذي سبق هذه الأحداث، ولا سيما بعد ما جرى في الساحل السوري، مطلع آذار/ مارس 2025، من أحداث أودت بحياة كثير من السوريين، وتعثّر الاتفاق بين الحكومة و(قسد)، كل ذلك ترك أثرًا نفسيًا ومجتمعيًا عميقًا، أسهم في تعميق الانقسامات بين السوريين، وشكّل بيئة خصبة لتأجيج الفتن لاحقًا. في هذا السياق المشحون، بدا أن أي حادثة، ولو كانت مفبركة مثل التسجيل الصوتي المتداول، يمكن أن تتحول إلى شرارة تؤدي إلى انفجار الوضع، كما حصل في الأحداث الأخيرة.
تقدّم هذه الورقة قراءةً في تلك الأحداث، وتحاول تحديد دور الفاعلين بها، وتعرض المواقف المحلية والإقليمية والدولية، والدور الاسرائيلي، مع استشراف سيناريوهات مستقبلية محتملة.
الأسباب غير المباشرة للأحداث
إلى جانب المناخ المتوتر، أسهمت مجموعة من العوامل غير المباشرة في تأزيم الوضع، وتشكيل بيئة خصبة للانفجار، وعلى رأسها وجود بعض الاحتقان بين بعض السوريين الدروز -أسوة بقطاعات واسعة من السوريين- من عدم إشراك مكونات من المجتمع السوري، في المؤتمرات السياسية التي نظمتها الإدارة الانتقالية مثل “مؤتمر النصر” و”مؤتمر الحوار الوطني”، ووجود آلاف الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في مؤسسات الدولة في عموم سورية (وفيهم أشخاص من تلك المناطق) وتشمل تلك الوظائف الجيش والأمن والشرطة والمؤسسات المدنية، وقد فُسّر ذلك بأنه سياسة إقصاء غير معلنة، والقلق من الهيمنة الأمنية لبعض الجهات القادمة من خارج البيئة المحلية، خصوصًا بعض التصريحات التي تتناقض مع أسلوب الحياة في مناطق السوريين الدروز، وتحفّظ المجتمع المحلي على مطالبة الدولة بتسليم سلاح الفصائل الدرزية، في حين يجري استيعاب فصائل أخرى ودمجها بالجيش الوطني من دون مطالبتها بالمثل، وعدم البدء بمسار العدالة الانتقالية، ما دفع البعض إلى السعي لأخذ “حقّهم” بأنفسهم، وهو ما أسهم في تغذية منطق الانتقام الفردي خارج إطار القانون، وانتشار خطاب الكراهية الطائفية على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حسابات مجهولة الهوية أو مموّلة خارجيًا، سعت إلى شيطنة مكوّنات مجتمعية معينة، وتغذية مشاعر الخوف والانقسام.
البداية في جرمانا وصحنايا
بدأت الأحداث فجر يوم الثلاثاء، 29 نيسان/ أبريل 2025، حيث هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة حاجزًا تابعًا للأمن العام عند مدخل مدينة جرمانا، من جهة المليحة (محور النسيم)، في تمام الساعة الثانية صباحًا، واستخدم المهاجمون رشاشات متوسطة وقذائف هاون، مما تسبب في حالة من الذعر، خاصة أن الاشتباك وقع في منطقة سكنية، وكان الحاجز يضمّ عناصر من الأمن العام، بعضهم من أبناء جرمانا، واستمر الاشتباك لنحو ساعة، قبل أن تصل تعزيزات من داخل المدينة. وفي الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا، عاود المهاجمون الهجوم، فوقع اشتباك جديد أسفر عن مقتل ثمانية من سكان جرمانا، وإصابة نحو ثلاثين آخرين بجروح، بعضهم في حالات حرجة، وقد تأخر وصول تعزيزات قوات الأمن العام إلى ما بعد وقوع الاشتباك الثاني، ما أثار انتقادات محلية.
ولم تتحول الأحداث في جرمانا إلى اشتباكات عنيفة، بسبب تدخل الجهات الحكومية وفصائل السويداء والمرجعيات الدينية لحل الخلاف، لكن المواجهات انتقلت في اليوم التالي إلى أشرفية صحنايا، وهي منطقة تضم سكانًا من المكون الدرزي ومكونات أخرى، وشهدت خلال الفترة الماضية توترات عديدة، وراح ضحية تلك الاشتباكات العديد من المواطنين، وغادر قسم كبير من أهالي الأشرفية باتجاه القرى السورية الدرزية في القنيطرة، وكذلك فعل بعض سكان جرمانا الدروز، ثم عادوا بعد هدوء الأوضاع.
قامت الحكومة بإرسال وفود رسمية إلى مناطق الاشتباكات، ضمّت المحافظين وبعض المرجعيات الدينية، بغية تهدئة الأوضاع، قبل أن تتوسع، لكنها امتدت إلى السويداء، حيث تحرّك رتل مسلّح من السويداء باتجاه أشرفية صحنايا، فوقعت اشتباكات عند منطقة الكسوة، مع مجموعات مسلّحة غير تابعة للأمن العام، راح ضحيتها مقاتلون من تلك الفصائل، وفي سياق تلك الأحداث اغتيل رئيس بلدية أشرفية صحنايا، بعد توقيع الاتفاق، وكان قد ظهر في فيديو مع قوات الأمن العام.
وبعد عدة اجتماعات بين وفود حكومية ضمّت المحافظين ومسؤول الأمن العام في ريف دمشق، مع وجهاء جرمانا وأشرفية صحنايا ووجهاء ومرجعيات دينية وسياسية وعسكرية قادمين من السويداء، بهدف احتواء الموقف والتهدئة؛ تم التوصل إلى اتفاق على انتشار الأمن العام في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتفعيل اتفاق آذار بين حركة رجال الكرامة والحكومة السورية، الذي كان ينص على أن يكون الأمن العام في السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا من أبناء تلك المناطق، على ألا يكون لهم سوابق جنائية، وتوزيع العناصر على الحواجز في جرمانا وفق “نظام المناوبات” لتكون الحواجز مشتركة بين متطوعي الأمن العام من المدينة ومن خارجها، وبدأ عناصر الأمن العام يتشكلّون من أبناء جرمانا 200، ومن الأمن العام 100، وتسلّموا هم الأمن بعد سحب السلاح المتوسط من أيدي الأهالي، وترك السلاح الخفيف فقط.
السويداء في قلب الأحداث
بعد الأحداث في جرمانا وأشرفية صحنايا، بلغت تداعيات الاشتباكات السويداء، وكانت قرية الصورة الكبرى قد تعرضت لهجوم مسلح من مجموعات غير منضبطة، وحصلت العديد من الانتهاكات بها. وقد أبرزت تلك الأحداث عمق الانقسامات بين الفاعلين السياسيين والدينيين والعسكريين في السويداء، بين مواقف متشددة تجاه الحكومة الانتقالية، متجاوزة خطاب الاحتجاج إلى مرحلة الصدام السياسي المباشر، وأخرى تحاول التوافق مع الحكومة، فبعد تعرّض الرتل القادم من السويداء لهجوم في الكسوة، وقتل عدد من عناصره، ظهر موقفان رئيسان هناك:
موقف المجلس العسكري المشكّل حديثًا في السويداء، وهو يضم ضباطًا منشقين مثل طارق الشوفي، حيث أعلن دعمه الكامل لمطالب الحكم الفيدرالي، ورفض تسليم السلاح أو انتشار الأمن العام في المحافظة دون ضمانات دولية، وقد دعم حزب اللواء السوري وتيار سورية الفدرالية هذا الموقف، وأعلنا تضامنهما مع الرافضين لاتفاقات التهدئة.
فصائل “رجال الكرامة” و”أحرار الجبل”، إذ أعلنا دعمهما الاتفاق الأمني، بشرط أن تكون عناصر الأمن العام من أبناء المحافظة الذين ليس لهم سوابق جنائية.
في بُعد رمزي لافت، التأم لقاء جمع مشايخ العقل: حكمت الهجري، حمود الحناوي، ويوسف الجربوع وغيرهم، في الثالث من أيار/ مايو 2025[1]، وانتهى بإصدار بيان يُعدّ أرضية تفاوض أولية غير معلنة، تمثلت في رفض أي عملية نزع سلاح داخل المحافظة، ما لم تُرفق بخطة تنفيذية واضحة، والتشديد على ضرورة أن يكون عناصر الأمن العام من أبناء السويداء حصرًا، مع مطالبة صريحة بضمانات تحول دون عسكرة الخلاف السياسي، وضرورة إطلاق حوار جاد وموسع مع العاصمة.
وترافق هذا مع انتشار أمني في محيط السويداء، خصوصًا في مناطق اللجاة ومدخل أوتوستراد دمشق-السويداء، في إشارة إلى أن الحكومة لا تزال تعتبر أن أي تصعيد من داخل المحافظة يجب أن يُعالج بتوازن بين الحوار والردع.
ثم حدث اتفاق بين ممثلي الحكومة السورية الانتقالية وممثلي السويداء على 5 بنود، من ضمنها تفعيل قوى الأمن الداخلي من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقًا، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء المحافظة حصرًا، ووقف إطلاق النار فورًا، وغيرها، وبدأ تنفيذ الاتفاق وعاد الهدوء، وبموجبه سيتكون الأمن العام من أبناء السويداء فقط، تحت اسم شرطة، وبلباس يختلف عن لباس الأمن العام.
باختصار، مثّلت السويداء في هذه الأحداث ساحة اختبار حقيقية لقدرة الحكومة الانتقالية على التعامل مع التعددية الداخلية، والاحتواء السياسي، وضبط التسلّح خارج المؤسسة العسكرية، كما كشفت الأحداث أن الانقسام داخل السويداء لم يعد دينيًا أو سياسيًا فقط، بل تحوّل إلى تداخل مع قوى إقليمية، سواء عبر الدعم (كما في حالة إسرائيل)، أو من خلال تأطير مطالب الحكم الذاتي وفق أجندات غير سورية.
الدور الإسرائيلي
مثّل التدخل الإسرائيلي الأخير نقطة تحوّل بارزة في مشهد التوتر جنوب سورية، إذ لم تكتفِ إسرائيل بالمراقبة أو الضغط السياسي، بل نفّذت ضربات جوية استهدفت محيط أشرفية صحنايا ومواقع أخرى، في خطوة عكست توجهها نحو لعب دور “الحامي الطائفي” في الساحة السورية، هذا السلوك الاستثنائي كرّس سابقة جديدة في نمط التدخل الإسرائيلي، اتسمت بالصراحة والعلنية، تحت ذريعة حماية أبناء الطائفة الدرزية، ما يؤشر إلى سعي واضح لتثبيت حضورها كطرف مؤثر في معادلات الجنوب السوري بعد سقوط النظام السابق.
وأعلنت رسميًا أن الضربات كانت “تحذيرية”، وجاءت لمنع ما وصفته بـ “مجزرة محتملة” ضدّ أبناء الطائفة الدرزية، الذين تعرضوا لهجمات من قبل ما سمتهم “مجموعات متطرفة”، كما شملت الغارات ضربة صاروخية قرب القصر الجمهوري في دمشق، بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق تهدئة بين الحكومة وممثلي الطائفة.
يحمل هذا التحوّل العديدَ من الدلالات، حيث أعلنت إسرائيل تبنّيها سياسة “حماية الأقليات” في سورية، وهي تربط تدخلها الجوي بمبررات طائفية، وظهرت تصريحات للشيخ موفق طريف (زعيم الدروز في إسرائيل)، شكر فيها رئيسَ الوزراء الإسرائيلي على “تدخلّه لإنقاذ دروز سورية”. ويأتي هذا التبني لعناوين الحماية الطائفية في ظلّ سياق داخلي إسرائيلي مشحون بسبب حرب غزة، ومحاولة نتنياهو حشد دعم الدروز داخل إسرائيل، وإظهار التزامهم بحماية إخوتهم في الخارج. وهو رسالة سياسية للحكومة الانتقالية السورية، حيث إن ضرب الموقع القريب من القصر الجمهوري لم يكن مجرّد تحذير عسكري، بل حمل رسالة سياسية رمزية، مفادها أن إسرائيل لا تعترف بالشرعية الكاملة للحكومة الانتقالية، وأن أيّ مسار تسوية لا يمرّ عبر مصالحها، أو لا يأخذ أمن حدودها بعين الاعتبار، سيبقى عرضة للخرق، وهذا ينسجم مع نهج “إدارة الفوضى” التي تبنّتها إسرائيل في الجنوب السوري منذ عام 2018، مع بعض الاختلاف حاليًا.
وتكمن خطورة هذا النموذج في مساسه بسيادة الدولة السورية، وفي قابليته للتكرار على مكونات أخرى، الأمر الذي ينذر بتفكك ما تبقى من العقد الاجتماعي السوري، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية جديدة تحت ذرائع “إنسانية” مشروطة، مما يكرس أشكالًا جديدة من الوصاية والانقسام.
وبالرغم من سعي إسرائيل لتقديم نفسها كجهة راعية للطائفة الدرزية، فإن معظم أبناء الطائفة الدرزية في السويداء وغيرها قابلوا هذا الطرح بالرفض، مشددين على انتمائهم للدولة السورية، ورفضهم القاطع لأي تدخل خارجي، وقد خرجت تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، استنكرت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدين أن حماية الدروز هي من صميم مسؤوليات الدولة السورية دون غيرها.
موقف الحكومة السورية الانتقالية
مثّلت أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء اختبارًا للحكومة السورية الانتقالية، بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، فهي لم تكن مجرد أزمة أمنية محدودة، بل فجّرت قضايا تتعلق بـقدرة الحكومة على فرض الأمن، وكفاءة مؤسساتها في استيعاب المكونات المختلفة، ومدى قابليتها لتقديم نموذج بديل للدولة التي ورثت عنها ملفات عديدة.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا أكّدت فيه أن التسجيل الصوتي المتداول الذي نُسِب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية هو تسجيل ‘”مزوّر، لا أساس له من الصحة”، إلا أن صياغة البيان أثارت بعض اللبس، خصوصًا في الجزء الذي رحّب بما وُصف بـ “فزعة المسلمين للذود عن نبيهم”، ما جعل البعض يراه بمثابة تفهّم ضمني لما جرى، رغم النفي الرسمي لوجود إساءة فعلية، وقد أسهم هذا التناقض في إثارة تساؤلات محلية حول الرسائل المتباينة التي حملها الخطاب الرسمي، ومدى انسجامه مع دعوات التهدئة التي صدرت لاحقًا.
تعاملت الحكومة مع الموقف بمقاربة مزدوجة، جمعت بين الاحتواء السياسي والانتشار الأمني دون الانجرار نحو حلول عسكرية شاملة، وقد تمثل ذلك في التهدئة الفورية وبناء القنوات، حيث أرسلت الحكومة وفودًا رسمية إلى المناطق المتوترة، برفقة مسؤولي الأمن العام، وعقدت لقاءات مع مشايخ العقل ووجهاء محليين، ونتج عن هذه اللقاءات اتفاقات تهدئة، وانتشار قوات الأمن العام في بعض المناطق.
وطرحت الحكومة خيار دمج الراغبين من أبناء تلك المناطق في صفوف الأمن العام، وفتح باب التطويع، كخطوة تهدف إلى إعادة الشرعية المجتمعية لأجهزة الدولة، كما طُرحت آلية لضبط السلاح، تقوم على استبعاد كل من لديه سجل جنائي أو من تورّط في تجارة المخدرات من الانضمام إلى الأجهزة الرسمية. وامتنع الخطاب الرسمي للحكومة الانتقالية عن توصيف الأحداث بوصفها “صدامًا طائفيًا”، وتم التشديد على أن المشكلة أمنية بحتة، تسببت بها “مجموعات متفلّتة”، وهذا الخطاب كان محاولة واضحة لاحتواء الطابع الطائفي للأحداث، ومنع تصديره إلى مناطق أخرى. وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، فقد كشفت الأحداث محدودية السيطرة الأمنية في مناطق ريف دمشق، وغياب مظلة قانونية موحدة يمكنها احتواء مطالب التيارات المحلية بطريقة مؤسسية.
ومثّلت هذه الأحداث فرصة للسلطات الجديدة في دمشق لتعزيز حضورها الأمني والإداري في مناطق سكن السوريين الدروز، وقد تم التوصل إلى اتفاقات تقضي بانتشار قوات الأمن العام في مناطق، مثل جرمانا وأشرفية صحنايا، مع اشتراط أن يكون معظم العناصر من أبناء تلك المناطق، ما سمح للحكومة باستعادة بعض حضورها الرسمي، دون الدخول في صدام مباشر مع الفصائل المحلية.
وعلى الرغم من خطورة الأحداث وما خلفته من قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، لم تُعلن الحكومة السورية الانتقالية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لتوضيح ما جرى في كل من جرمانا وأشرفية صحنايا، وتحديد المهاجمين للأمن العام والمدنيين بهما، الأمر الذي أثار استغرابًا لدى العديد من الفاعلين المحليين، ويُعدّ غياب مثل هذه اللجنة فرصةً ضائعة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة، ولفرض رواية مؤسساتية واضحة حول ما جرى، بعيدًا عن التأويلات والانفعالات.
وتُظهر بعض المؤشرات أن التصعيد الأخير لم يكن مجرد نتيجة لتوترات محلية أو أخطاء في المعالجة الأمنية، وأنه ربما يحمل أبعادًا سياسية داخلية أيضًا، فقد فسّر البعض ما جرى على أنه محاولة لإحراج القيادة الجديدة في دمشق، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع، الذي تبنّى منذ تسلمه السلطة نهجًا مرنًا في التعامل مع المكوّنات السورية، وأرسل إشارات انفتاح تجاه المجتمع الدولي. وقد يكون هذا النهج محلّ اعتراض من دوائر أكثر تشددًا داخل أجهزة الدولة أو من بعض الفصائل التي ترى في أي تسوية تهديدًا لمكتسباتها، وفي هذا السياق، جاءت بعض الأحداث لتقوّض خطابه المعتدل، وتدفعه إلى التراجع أو إلى المواجهة، ما يضع الحكومة الانتقالية أمام اختبار مزدوج: أمني وسياسي.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
تباينت المواقف الإقليمية والدولية تجاه هذه الأحداث والتصعيد الإسرائيلي، واتسمت بالتأكيد على ضرورة ضبط النفس وعدم الانخراط في أي مسارات قد تؤدي إلى تأجيج الانقسامات الطائفية، حيث دانت تركيا الضربات الإسرائيلية، واعتبرتها توظيفًا انتهازيًا للتوتر الداخلي في سورية، متهمة تل أبيب بمحاولة تصدير أزمتها في غزة إلى الساحة السورية. ووصفت فرنساطبيعة العنف المسجّل في مناطق التوتر بأنه يهدد بمفاقمة الصدع المجتمعي داخل سورية، وطالبت جميع الأطراف بوقف الأعمال التصعيدية، مشددة على ضرورة التزام الحكومة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على النظام العام ومنع تكرار هذه الأحداث. وعبّرت الأردن عن أهمية الحفاظ على التوازن المجتمعي في المناطق المختلطة، وأكدت ضرورة تعزيز قيم التعايش بين المكونات المختلفة، بما يمنع تحول التوترات الموضعية إلى صراعات مفتوحة، كذلك دانت معظم الدول الإقليمية والعربية هذا التدخل والقصف، وكان هذا الموضوع من القضايا التي طُرحت خلال زيارة الرئيس الشرع لفرنسا ولقائه بالرئيس ماكرون، مما يدل على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للدول الغربية.
في السياق ذاته، سارع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى زيارة دمشق، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أكّد دعمه للدولة السورية، ورفضه المطلق لأي “حماية دولية” للطائفة، في رد واضح على طرح الشيخ حكمت الهجري.
كذلك عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها حيال تصاعد العنف الطائفي، وأكدت خطورة استهداف المدنيين والأجهزة الأمنية، مع الدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة، وأكدت وجوب احترام سيادة سورية وتفادي أي تدخلات خارجية تحت ذرائع إنسانية.
وتُظهر مجمل ردود الفعل الدولية والإقليمية أنها نظرت إليه من زاوية هشاشة الوضع الانتقالي في سورية، وعدّته إحدى نقاط الاختبار لمدى قدرة الحكومة الجديدة على تجنّب الانجرار إلى صراعات داخلية، ومنع استغلال هذه الأحداث في مشاريع خارجية قد تعرقل مسار التسوية السياسية.
ألقت هذه التطورات بظلالها على صورة الحكومة السورية الانتقالية في الأوساط الدولية، إذ أثار تصاعد العنف الطائفي تساؤلات حول مدى قدرتها على بسط الأمن وضمان حماية المكوّنات المجتمعية، وهو ما يُعدّ عنصرًا أساسيًا في تقييم المجتمع الدولي لأيّ سلطة ناشئة في مرحلة ما بعد النزاع، وقد اعتبرت بعض العواصم الأوروبية أن هذه الأحداث، رغم أنها موضعية من حيث الجغرافيا، تُظهر بعض الهشاشة في البنية الإدارية والأمنية الجديدة، مما قد يُبطئ أو يعقّد أي تحركات مستقبلية باتجاه تخفيف العقوبات أو تقديم دعم تنمويّ مباشر، ما لم تُعالج الجذور السياسية والاجتماعية للتوترات بشكل واضح ومؤسسي.
السيناريوهات المستقبلية
تكشف تطورات أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء عن أزمة مركّبة، وتطرح تحديات تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمكونات الاجتماعية، في ظلّ مرحلة انتقالية لم تتبلور فيها بعد قواعد الحوكمة، ولا آليات إدارة التنوّع المحلي. وفي ضوء التفاعلات المعقدة بين الداخل السوري والعوامل الإقليمية، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الأحداث، تختلف في مستوى التصعيد، وحدود الانخراط المحلي والدولي.
السيناريو الأول: الاحتواء التدريجي وبناء توافقات محلية
يُعدّ هذا السيناريو الأكثر واقعية وانسجامًا مع متطلبات الاستقرار المحلي، حيث يُفترض أن تعتمد الحكومة الانتقالية نهج التهدئة التدريجية، عبر الانخراط في تفاهمات مرنة مع القيادات الدينية والاجتماعية المعتدلة. ويهدف المسار المقترح إلى تفكيك البنية المسلّحة بصورة تدريجية ومنظمة، من خلال تنفيذ اتفاقات محلية تتعلق بتسليم السلاح، وفق جدول زمني واضح، مع ضمان إعادة هيكلة قوى الأمن العام، بما يسمح بدمج أبناء المناطق المتوترة، ويتطلب هذا السيناريو تفعيل آليات حوار دائمة، مع مشايخ العقل والفصائل المحلية، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وفتح الطريق نحو استقرار طويل الأمد دون اللجوء إلى العنف أو الإقصاء.
ويرتبط تحقيق هذا السيناريو بفاعلية الضمانات الحكومية، ووجود دعم إقليمي سياسي (خصوصًا من تركيا والأردن ولبنان وبقية الدول الفاعلة في الشأن السوري)، ومحاصرة الخطاب التحريضي الطائفي، عبر شبكات التواصل الموجّهة والمموّلة خارجيًا، كما يرتبط بنجاح السلطات الجديدة في ضبط الفصائل والعناصر المنفلتة، وتفكيك الفصائل ودمجها في الجيش الوطني الجديد.
2- السيناريو الثاني: التصعيد المتدرج نحو مواجهة داخلية شاملة
يبرز هذا السيناريو بوصفه الاحتمال الأكثر خطورة، في حال تعثّر مسار التهدئة بين الحكومة الانتقالية والفصائل المحلية في السويداء، سواء أكان ذلك بسبب فشل الحوار، أو بسبب تراجع السلطات عن تنفيذ تعهداتها المتعلقة بإدماج أبناء المحافظة في الأطر الأمنية، أو بسبب انعدام الشفافية في إعادة هيكلة المؤسسات المحلية، أو بسبب عدم قدرة الحكومة السورية الانتقالية ضبط الفصائل والعناصر المنفلتة. ومن شأن استمرار هذا الجمود السياسي والأمني أن يُمهّد لانزلاق تدريجي نحو صراع داخلي مفتوح، يبدأ باشتباكات محدودة بين أطراف متعارضة، مثل “المجلس العسكري” الرافض للتسوية، وبين فصائل مثل “رجال الكرامة” و”شيوخ الكرامة”. وقد تلجأ الفصائل المتشددة إلى توظيف وسائل ضغط رمزية وميدانية، كإثارة الفوضى أو استهداف رموز ذات دلالة معنوية، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي، ويُقوّض في الوقت ذاته صورة الدولة الانتقالية كمرجعية ضامنة للسلام الأهلي.
في هذا السيناريو، تصبح السويداء ساحة صراع مركّب، تُستثمر فيها الفوضى من قبل شبكات تهريب السلاح والمخدرات التي تزدهر في ظل غياب الدولة، مما يُكرّس اقتصادًا مسلحًا موازيًا يصعب تفكيكه لاحقًا.
وهناك سيناريو آخر، لكنه مستبعدٌ حاليًا، وهو التدويل التدريجي للملف الدرزي، ويُعد سيناريو التدويل خطرًا حقيقيًا، إذا تصاعد التدخل الإسرائيلي، أو طُرحت مطالب دولية بحماية خاصة للطائفة السورية الدرزية، ما قد يُستخدم لترويج سردية اضطهاد ديني تبرّر تدخلًا خارجيًا، هذا المسار يُضعف شرعية الحكومة الانتقالية، ويُهدّد احتكارها للقرار الأمني والسياسي، ويفتح المجال لتدخلات دولية وفرض ترتيبات فدرالية غير سورية تحت غطاء حماية الأقليات.
التوصيات
بعد الأحداث الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي، ارتفعت احتمالية استغلال الأحداث الداخلية في سورية من طرف الدول الإقليمية، مما يقتضي تبنّي مقاربة متوازنة تجمع بين ضبط الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتقوم على المحاور الآتية:
إصلاح أمني ومؤسسي:
فتح باب الانتساب أمام جميع مكونات الشعب السوري، ودمج العناصر المنضبطة من أبناء المناطق ضمن الأمن العام، واستبعاد المتورطين في الجرائم أو تجارة المخدرات.
حصر السلاح بيد الدولة، عبر نزع تدريجي وتدقيق أمني صارم، مع عدم التمييز بين مجموعة وأخرى.
التنسيق الأمني مع دول الجوار والدول الفاعلة في الشأن السوري.
وضع استراتيجية واضحة لبرامج DDR/SSR، تبدأ بوضع هيكلية واضحة للجيش الجديد، وخارطة طريق محددة زمنيًا.
تعزيز الحوار وبناء الثقة:
إطلاق حوار محلي تشاركي مع المرجعيات الدينية والسياسية والمجتمعية، لتثبيت التهدئة، وتقديم المرجعيات السياسية والاجتماعية أولًا.
تشكيل لجان محلية للإشراف على تنفيذ الاتفاقات، ومتابعة ملفات التطويع والنزاع.
تقديم ضمانات قانونية بعدم الملاحقة لمن لم يرتكب انتهاكات.
مشاركة حقيقية في السلطة.
تحصين الخطاب الوطني والإعلامي:
مواجهة حملات التحريض الطائفي، عبر إصدار بيانات وتصريحات توضح ماهية الأحداث الجارية، وخطوات الحكومة تجاهها.
تأكيد احترام التعددية ضمن إطار الدولة، دون الوقوع في منطق المحاصصة أو الاستثناء الطائفي.
الربط بين الأمن والتنمية:
إطلاق مشاريع تنموية صغيرة في المناطق الخارجة من التوتر، كحافز للاستقرار.
دعم برامج إعادة الدمج المجتمعي، وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تضمّ شخصيات سياسية وقانونية، يكون لها نظام أساسي وآلية عمل معلنة وقواعد ملزمة.
خاتمة
وضعت الأحداث الأخيرة الحكومة السورية الانتقالية أمام اختبارٍ لقياس مدى تمكنّها من السيطرة الأمنية وإدارة التنوع الاجتماعي، في ظل غياب إجماع سياسي، وتدخلات إقليمية ودولية، وكشفت عن حجم الانقسامات داخل مجتمع السويداء، وهي انقسامات لم تعد دينية فقط، بل أصبحت سياسية وعسكرية، وعن تنافس على تمثيل المجتمع المحلي وقيادته، بين اتجاه يدعو إلى الانخراط في مشروع الدولة الجديدة، وآخر يسعى إلى مزيد من الاستقلالية، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات فإنها ما تزال هشّة ومعرضة للاختراق.
وتُبرز الأحداث الأخيرة عمق التحديات التي تواجه سورية في المرحلة الانتقالية، حيث لم تكن مجرّد اضطرابات أمنية موضعية، بل كشفت هشاشة التوازنات المجتمعية، وتضارب الأجندات المحلية والإقليمية، وأعادت طرح سؤال جوهري حول قدرة الحكومة الانتقالية الجديدة على احتواء التنوع المجتمعي وضبط التفلت الأمني دون السقوط في فخ الطائفية، أو إعادة إنتاج منطق المحاصصة الذي يقوّض مفهوم الدولة الحديثة.
في المقابل، شكّل التدخل الإسرائيلي سابقة خطيرة، لا في طبيعته العسكرية فحسب، بل في تبنيه العلني لخطاب الحماية الطائفية، وهو ما ينذر بتحويل مسألة الأقليات في سورية، إلى أداة تدويل واستثمار سياسي دائم، وتكمن خطورة هذا التدخل في كونه قد يشكّل نموذجًا قابلًا للتكرار تجاه مكونات أخرى في المجتمع السوري، كالمسيحيين أو الأكراد أو العلويين، وهو ما يُقوّض بشكل مباشر مبدأ السيادة الوطنية، ويهدّد وحدة القرار العسكري والأمني للدولة.
ومما زاد المشهد تعقيدًا أن جزءًا من التصعيد الطائفي الذي شهدته المناطق المتوترة كان مدفوعًا بحملات إعلامية، تحركها حسابات وهمية مجهولة التمويل، تعمل على تغذية الانقسام والكراهية، في إطار ما يمكن وصفه بـ “حرب معلومات موجهة”، تستهدف إضعاف مسار الانتقال السياسي وتفجير المجتمع من الداخل.
في نهاية المطاف، لا يتمثل التحدي الأساسي في احتواء الأزمات المتفجرة فحسب، بل في القدرة على تحويل التسويات المؤقتة إلى مسارات مستدامة، تقوم على شراكة محلية حقيقية، وعدالة مؤسساتية، وسيادة دولة موحدة، ويتطلب ذلك تجنّب الوقوع في فخ المحاصصة الطائفية أو أشكال الوصاية المبطّنة التي تعوق بناء عقد وطني جامع.
وعلى الرغم من نجاح الجهود المباشرة في احتواء الأزمة الحالية، فإن خطر تجدد العنف الطائفي لا يزال مرتفعًا بصورة مقلقة، في ظل غياب معالجات عميقة لجذور التوترات الكامنة، ومما يُفاقم من هشاشة الوضع أن السلطات الانتقالية لم تطوّر حتى الآن آليات فعّالة للإنذار المبكر بشأن التهديدات الطائفية، فضلًا عن غياب استجابات سريعة تحول دون تصاعد العنف وتحمي المدنيين من آثاره الكارثية.
تكشف هذه الأحداث هشاشة الوضع، وصعوبة بناء نظام سياسي قادر على استيعاب التنوّع وإداراته، من دون الوقوع في فخ الطائفية أو الفوضى، وإن النجاح في احتواء التوترات يتطلب أكثر من مجرد اتفاقات أمنية، إذ يتطلب مشروع دولة يتأسس على الشراكة والعدالة والوضوح المؤسسي، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو الإقصاء.
[1] اتفاق السويداء… خطوة نحو الاستقرار أم ترتيب أمني هش؟، العربي الجديد، 04 أيار/ مايو 2025، شوهد في 5 أيار/ مايو 2025 https://bit.ly/44p4zfg
تحميل الموضوع
مركز حرمون
—————————————
سوريا: احتقان في المدن الجامعية وشهادات خاصة للطلاب الدروز/ منهل باريش
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محتوى المقاطع المصورة التي تظهر حالات توتر وخطابات طائفية في الجامعات السورية ومرافقها، وأكد أن هدفها إثارة الفتنة والانقسامات الطائفية بين الطلبة.
بعد يوم من وصول آخر القوافل التي تقل الطلاب من أبناء طائفة «الموحدين الدروز» إلى محافظة السويداء، انتشرت أشرطة مصورة تظهر عشرات الطلاب من أبناء الدروز في عدة مدن جامعية يجرون حقائبهم وكأنهم في رحلة هجرة جماعية. واتضح أن الفيديوهات المتداولة صُورت نهاية نيسان (ابريل) مع التجييش الطائفي والأحداث والعمليات الأمنية التي حصلت في جرمانا وصحنايا مطلع أيار (مايو) الجاري. ويفسر انتشارها اليوم بحالة الخوف الكبيرة التي انتابت الطلاب وأهاليهم في الحرص على عدم تداولها وانتشارها قبل وصولهم إلى منازلهم الآمنة.
الجدير بالذكر أن الشحن الطائفي ضد الدروز بدأ مع انتشار تسجيل صوتي مفبرك قيل انه لشاب من السويداء، وركب الصوت على صورة أحد المشايخ الدروز وتبين لاحقا عدم صحة مصدره. إلا أن التسجيل الذي يحمل شتائم تطال شخص الرسول الكريم، انتشر كالنار في الهشيم في ظل توتر كبير في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة والمرجعيات الدينية في السويداء.
تركزت حالة الشحن في المدن الجامعية باعتبارها المناطق الأكثر اختلاطا بين المكونات السورية، حيث بدأت في السكن الجامعي بحمص وانتقلت إلى دمشق وحلب بشكل أقل، في حين كان الاحتكاك بين الطلاب في أدنى حالاته في المدينة الجامعية باللاذقية على اعتبار أن نسبة كبيرة من الطلاب الدروز غادروا عقب أحداث الساحل في اذار (مارس) الماضي.
في المدينة الجامعية بحلب، تعرض الطالب في كلية الهندسة الميكانيكية (أ. غ) إلى هجوم من عدة أشخاص بلا سبب أو احتكاك مباشر، حيث هاجمه ستة طلاب اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وطعنه أحدهم بالسكين عدة طعنات في الصدر والبطن والكتف حسب ما تظهر الصورة وتقرير الطبيب المسعف بمستشفى حلب الجامعي.
وتنشر «القدس العربي» التقارير الطبية من ملف المعتدى عليه والذي يشير إلى أن الطالب المذكور تعرض إلى الطعن بالسكين في الصدر والعضد والكتف، ما تسبب في حدوث ريح صدرية رضية، إثر دخول السكين إلى عمق 3 إلى 4 سم في غشاء الجنب وثقب الرئة بين الضلع الثالث والرابع على الجهة اليسرى (جهة القلب).
ويوضح التقرير الطبي أنه تم إجراء تفجير للصدر في الطرف اليساري بسبب الريح المذكورة والنزف الداخلي. كما جرى وضعه على خطة علاج مناسبة. ونوه الطبيب أن المريض أُخرج من المستشفى على مسؤوليته، وشخص حالة المصاب بانها «شبه مستقرة».
وفي تفاصيل الحادثة، قال (ت. غ) شقيق المعتدى عليه وهو طالب جامعي أيضا، إن العائلة والمشيخة الدرزية طلبت الامتناع عن تقديم أي شكوى أو ادعاء، وعلل ذلك، «حتى لا يزيد الأمر من حالة الشحن أو يتسبب باعتداء جديد»، وزاد «كان هم الشيوخ وصول جميع الطلاب إلى السويداء دون تعرض لهم من قبل المهاجمين والمشحونين طائفيا». وأضاف «أبلغنا مسؤول أمن الجامعة عن رغبتنا بعدم الشكوى على الطلاب المهاجمين. بعدها أحضر الطالب إلى المستشفى وأقر بطعن أخي بالسكين واعتذر عن فعلته» نفى أن يكون الطالب المهاجم قد سجن بتهمة الحق العام.
على الجانب الآخر، قال مصدر أمني في جامعة حلب، إن الطالب المعتدى عليه رفض كتابة ضبط الشرطة وبعد يومين من الحادثة طلب من مدير أمن الجامعة تميم ابو عمر ان يرعى صلحا مع المعتدي و«اشترط تقديم الاعتذار فقط»، وبالعفل فإن المسؤول أحضر المعتدي واعتذر من المعتدى عليه وهو على سريره في مستشفى المدينة الجامعية، وتذرع بأنه وقع تحت «ضغط العاطفة» من خلال الشريط الصوتي المفبرك.
وفي ذروة الاحتجاجات ظهر تميم ابو عمر معترضا على مظاهرة طلابية تهتف ضد سلمان الهجري ابن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، قائلا للمتظاهرين «نحن مؤسسة تعليمية والعبارت الطائفية ممنوعة في الحرم الجامعي، وكما لديك رموزك ولا تريد لأحد أن يسيء لها، فإن للآخرين رموزهم ولا يجوز الإساءة لهم».
وفي سياق منفصل، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر طلاب وطالبات من محافظة السويداء في جامعة حلب، وهم يعودون بشكل جماعي إلى مدينتهم بعد إعادة فتح طريق دمشق- السويداء. وذكر الطالب (ت. غ) أن طلاب السويداء قرروا العودة إلى محافظتهم بعد تعرضهم لحملة من التجييش والشحن الطائفي ضدهم بسبب انتمائهم لطائفة «الموحدين الدروز»، وعلى خلفية الأحداث التي اندلعت في كل من جرمانا وأشرفية صحنايا وما تبعها من توترات سياسية وعسكرية بين السلطة الحالية والقوى السياسية والفصائل العسكرية والزعامة الروحية للموحدين الدروز.
وفي سكن الهندسة الميكانيكية والكهربائية الجامعي بدمشق والمعروف باسم «سكن الهمك» اختصارا والواقع على المتحلق الجنوبي، قال الطالب في إحدى كليات الهندسة (م، ش) إن طلابا من الطائفة السنية قاموا بهتافات ضد الطلاب الدروز وأطلقوا شعارات نابية بحقهم، وجرى احتكاك عدة مرات وتدخل الأمن العام واعتقل طلابا من الطرفين واقتادهم إلى مقر الأمن العام الحالي في «فرع فلسطين» المجاور للسكن، إلا أن «حالات التحرش والهجوم الكلامي لم تتوقف.. ولم توفر حتى الطالبات» حسب قوله.
وفي المدينة الجامعية في المزة، قال طالب في السنة الثانية بمعهد التعويضات السنية- اشترط عدم ذكر اسمه- أنه خائف من العودة إلى الجامعة وذكر انه يفضل عدم إكمال دراسته على تعريض حياته للخطر. ونوه إلى أن «دروس مادة العملي مستمرة ونحن متغيبون عنها وامتحاناتنا النهائية مطلع شهر حزيران (يونيو)» ويزيد متحسرا «لقد خسرت تعبي في المعهد لمدة عامين وحملت أهلي عبئا ماليا كبيرا». وشارك «القدس العربي» شريطا مصورا لطلاب في مظاهرة يحملون أعلام بيضاء مطبوع عليها عبارة «لا إله إلا الله» يتوعدون من خلالها دروز السويداء وجرمانا. بموازاة ذلك، أعاد ناشطون آخرون تداول مقاطع فيديو لعودة طلاب وطالبات من سكن جامعة دمشق في حي المزة، ومع تصاعد الانتقادات، أطلق مسؤولون سوريون تصريحات تخفف من انتقاد السلطات واتهامها بعدم توفير الحماية للطلاب داخل الحرم الجامعي. وفي تعليقات، أشار مدير المدينة الجامعية في دمشق عمار الأيوبي، في تصريح لقناة «الإخبارية السورية» إلى أن مقاطع عودة طلبة السويداء من جامعة ومعاهد دمشق ليست جديدة، وتعود إلى نهاية نيسان (ابريل)، على خلفية انتشار المقطع الصوتي المسيء للرسول. وكانت وزارة الداخلية السورية أكدت أن المقطع الصوتي لا يمت للشيخ بصلة ولا يمكن نسبه له، وأضاف الأيوبي، أن طلبة السويداء حينها غادروا المدينة الجامعية برغبتهم وبدون أي ضغوط عليهم من قبل إدارة الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تتعامل مع كافة الطلبة بشكل حيادي ولا تتبنى أي خطاب طائفي أو مذهبي.
ونفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان علبي، محتوى المقاطع المصورة التي تظهر حالات توتر وخطابات طائفية في الجامعات السورية ومرافقها، وأكد على أنها قديمة، وهدفها إثارة الفتنة والفوضى، والانقسامات الطائفية بين الطلبة.
وأضاف الوزير في منشور على منصة «فيسبوك»، أن «العلاقة بين الطلبة داخل المدن الجامعية يسودها جو من التفاهم والتوافق الأهلي، مع حرص جميع الأطراف على الحفاظ على الاستقرار والاحترام المتبادل، بعيدًا عن أي محاولات لبث الفتنة أو زرع الشقاق بين مكونات المجتمع الطلابي»، كما طلب من وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يتحروا الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها، والتوقف عن نشر المقاطع المصورة القديمة التي من شأنها أن تثير «البلبلة غير المبررة في المجتمع الطلابي».
وكانت شبكة «الراصد» المحلية المختصة بتغطية الأخبار في السويداء، قد نشرت الخميس الفائت تعليقًا على مقاطع عودة طلبة السويداء من حلب قائلة «في وقت يتابع فيه آلاف الطلبة السوريين دراستهم الجامعية بشكل طبيعي، يقبع طلبة محافظة السويداء في المنازل، لا بسبب إهمال دراسي أو عقوبة جامعية، بل لأن الخروج إلى الجامعة بات مغامرة قد لا يعودون منها أحياء».
وفي مقطع مصور آخر، أجرت «الراصد» لقاء مع أحد الطلبة العائدين من جامعة حلب، قال فيه «أن الأمن العام كان مرافقا بشكل كامل لطلبة السويداء بعد أن تم جمعم في وحدة سكنية واحدة، وأنه أكد للطلبة أن الوضع حساس بسبب التجييش الطائفي، ما دفعهم للمغادرة بعد فتح طريق دمشق- السويداء».
ولفت الطالب في المقطع المصور، إلى أن حالات التجييش الطائفي قابلتها أيضا حالات من التضامن من طلبة آخرين ومحاولات للوقوف معهم، وتهدئة الأوضاع.
بدوره وجه محافظ السويداء، مصطفى البكور، رسالة إلى أهالي المحافظة عبر «الإخبارية السورية» أكد فيها على أن السلطة تقف أمام مسؤوليتها عن حفظ وسلامة أبناء المحافظة من الطلبة، وفي هذا الصدد أجرى اتصالا مع وزير التعليم العالي الذي أكد بدوره على «حقوق طلاب محافظة السويداء وغيرهم من المحافظات والحفاظ على كرامتهم ومنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان» متعهدا بتعويض «الفاقد التعليمي للطلاب المتضررين».
الجدير بالذكر، أن عددا من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السوري حاولت مناصرة قضية الطلبة، والمشاركة في تهدئة الأجواء، ومنها مبادرة «الطائفة السورية» التي تضم عدة منظمات وعددا من النشطاء في مدينة حلب، والتي أصدرت بيانا قالت من خلاله إن المشاركين في المبادرة أجروا عدة زيارات لطلبة السويداء المقيمين في حلب، واطلعوا على مشاكلهم، وأبدوا لهم استعدادا لتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والاجتماعي واللوجستي، والعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة لهم تضمن كرامتهم وسلامتهم واستمرارية تعليمهم.
وختمت المبادرة بيانها بالقول إن «حلب جزء من سوريا وهي مدينة لكل السوريين»، داعية إلى «تعزيز قيم التضامن الأهلي والوحدة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والعنف بكافة أشكاله».
ويتعين على الإدارة الجديدة بذل جهد كبير لتطمين الطلاب وأهاليهم واقناعهم بالعودة إلى جامعاتهم، الفشل بذلك يعني عمليا أن الإدارة السورية غير قادرة على تأمين الحماية للطلاب في جامعاتهم وأنها تميز بين الطلاب على أساس انتمائهم الطائفي وهو أمر في غاية الخطورة.
القدس العربي
——————————–
علمانية الطوائف السورية/ ابتسام تريسي
12/5/2025
مصطلحان اثنان نالهما الابتذال أكثر من أيّ شيء مبتذل في الواقع السوري اليوم، الأوّل لوضع العصي بالعجلات، والثاني لتعطيل تحقيقه، وهما العلمانية، والعدالة الانتقالية. فأن تطلب العلمانية من حكومة جاءت من منبت ديني متشدد فهذا يعني أنك لا تريد لهذه الحكومة أن تحقّق أيّ هدف وضعته رغم تخليها (خطابيًا) عن هذا التشدد. أمّا عمليًّا فتحتاج لبعض الوقت؛ كي تحوّل أقوالها لأفعال، هذا الوقت الذي لا يريد المعترضون السوريون أن تحصل عليه.
أمّا العدالة الانتقالية -إن تحققت- فستطول رؤوسًا كثيرة جدًا لا يرغب المعترضون بأن تُحاسب، وكثير منها يُشكّل قوام القوة العسكرية التي حاولت الانقلاب على السلطة الجديدة، بدايةً في الساحل السوري، ثمّ في الجنوب السوري، وهذا يُفسِّر حالة التعنت الشديد الذي يتمسك به “حكمت الهجري” القائد الروحي لجزء من الدروز، والمتبني للمجلس العسكري الذي يريد تحرير دمشق من سلطة الأمر الواقع.
شعارات المعارضة الحديثة
“نريد سوريا علمانية مدنية يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، ويكون للمرأة دورٌ بارز في إعادة بناء الدولة”. شعار سمعناه آلاف المرات من نخب ثقافية بارزة حينًا، ومتواضعة أحيانًا، نادى به مثقفون سنّة يساريون، ومثقفون علويون، ودروز، وأكراد، وامتلأت به مساحات السوشيال ميديا المقروءة، والمسموعة، والمرئية.
لن أتطرق بالشرح لمفهوم العلمانية فهو متاح لكلّ باحث، لكنّي سأذكر أحد الآراء التي رجعت للعصر الأندلسي واستخرجت بذرة الفكرة من ذلك العهد، إذ لما رأى المسيحيون في الأندلس المسلمين وعلاقتهم بربهم -حيث لا واسطة بين المسلم وربه- طالبوا بأن يكونوا مثلهم، وأن يجدوا طريقة يتخلصوا بها من الوسيط بين المسيحي وربه، هذا الوسيط الذي يبيعهم صكوك الغفران، ويفرض عليهم الأتاوات، ويتواطأ مع الملوك لإخضاعهم لسلطة الكنيسة، نمت هذه البذرة، وتكاثرت أغصانها لتغدو في زمن الثورة الفرنسية شعارًا يردده الفرنسيون جميعًا (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قس).
مأزق اليساريين السوريين
لقد مرّ زمن طويل جدًا ليقتنع عامة الناس بفكرة العلمانية التي فرضها الشعب عبر ثورة عظيمة بعد أن هضم الفكرة جيدًا. أمّا في سوريا وفي بلادنا العربية عمومًا، فغالبًا لا نجيد إنتاج الأفكار، ونستسهل استيرادها، ونبرّر ذلك بحجة الاستفادة من تجارب الشعوب بغض النظر عن مكونات الخلطة الكيميائية المتباينة بين هذه الشعوب، ونتوقع دائمًا الحصول على النتيجة ذاتها. فاليساري السوري الدرزي ينضوي تحت لواء شيخ العقل، ويمتثل لأوامره، ومن ناحية ثانية يمنع الميراث عن أخته، وإذا تزوجت من غير الطائفة يقتلها، وفي الوقت نفسه يُطالب بدولة علمانية، حتى أنّ الابتذال وصل حدَّ مطالبة شيخ العقل ذاته بدولة علمانية وفي الوقت نفسه يضع على بدلة رجل الأمن الذي عيّنه شعار (يا سلمان) فكيف يطالب الشيخ بفصل الدين عن الدولة، أليس من الأولى أن يعزل نفسه أولاً، ثمّ يتقدم بمثل هذا الطلب؟
العدالة الانتقالية القشة التي يتعلّق بها المجرمون
أمّا عن العدالة الانتقالية فلا ذكر لها عند الشيخ حكمت ومجلسه العسكري وقد وصل به الأمر حد المطالبة بإعادة عناصر الجيش، ودفع رواتب للمجرمين المختبئين في مجلسه العسكري، رغم أنّ بعضهم من كبار المجرمين في العهد البائد.
في الجانب الآخر، وكي لا يبدو الأمر دفاعًا عن طائفة بعينها نجد بعض اليسار السنّي يقع في الحفرة ذاتها إذ نراه يتلعثم عند ميراث أخوته البنات، وقد يستعيد إيمانه بالله إن اقتضت المصلحة ذلك.
أما الجماعة الكردية التي تأوي عصابة قنديل (pkk ) فالأمر لا يتوقف عند هذه التناقضات، بل يتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك فاختطاف القاصرات والأطفال وتجنيدهم عسكريًا في خدمة حزب العمال الكردستاني يُعد جريمة الجرائم التي لا يقبل بها دين أو نظام علماني على وجه الأرض، ومع ذلك يريدون سوريا علمانية.
الأسد فكرة والفكرة لا تموت!
هذا الواقع الأسود الذي تعيشه سوريا اليوم، هو نتاج طبيعي لما أفرزه الاستبداد الأسدي الذي جعل من السهولة بمكان ارتباط بعض المكونات بأجندات خارجية تلعب في الملف السوري كما تشاء مصالحها، يُساعد في ذلك مجمل الأخطاء التي وقعت فيها السلطة الجديدة والتي تحاول جاهدة تسوية النزاعات بطرق سلمية قد تضطرها لتنازلات هي بغنى عنها، خاصة وأنّها تعلم جيدًا أنها مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي بدستور يرضى عنه العالم (المتحضر) قبل الشعب السوري الذي ما زال ينتظر العدالة الانتقالية، ورفع العقوبات الأمريكية عنه؛ كي تبرأ جراحه.
وعلى هذا الأساس ينظر السوريون المعتدلون إلى النشاط الخارجي للرئيس الشرع نظرة أمل لإيجاد حلّ للوضع السوري في أقرب وقت، بينما يحاول الطائفيون العلمانيون التغطية عليه بنشر قصص الخطف والاضطهاد من قبل الدولة الإرهابية.
فقد طلب مشايخ الدروز من العائلات الدرزية إعادة أبنائهم من جميع الجامعات السورية إلى السويداء، وانتشرت الفيديوهات التي علّق عليها الإعلامي الدرزي المعروف بمواقفه المُشرّفة من الثورة السورية منذ انطلاق شرارتها الأولى، قائلًا: “الرحيل الجماعي لطلاب السويداء من جامعاتهم في المحافظات السورية -بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم على خلفية انتمائهم الديني-خبرٌ لن تجد له أثرًا في الإعلام المسمّى وطنيًّا! يا لعارنا!”. وللأسف لم يكن ماهر شرف الدين وحده الذي تبنّى التحريض الطائفي علنًا، بل كثر من مثقفي وإعلامي الطائفة.
وعلى الطرف الآخر ارتفعت نسبة شيطنة السنة من قبل العلويين الذين ركبوا ترند “السبي” فراحوا ينشرون صورًا لفتيات مخطوفات على أنّهنّ سبايا “الأمن العام” وأنّ إدلب صارت سوقًا للسبايا. ويتبين بعد أيام أنّ الخبر كاذب، وتظهر الفتيات في فيديوهات مسجلة ينفين تعرضهنّ للخطف، لكنّ المحرضين لا يتوقفون، ويستمرون في تسويق أوهامهم التي يتمنّون لو كانت حقيقة؛ كي يستطيعوا الطعن في الحكومة وتكريس صفة الإرهاب عليها.
المصدر : الجزيرة مباشر
———————————
عن رفات جنود إسرائيليين في سورية/ حسام أبو حامد
13 مايو 2025
لم تكن تفصلني سوى خطوات قليلة عن السور الجنوبي لمقبرة الشهداء (المقبرة القديمة) الواقعة في حي المغاربة، جنوب شرقي مخيّم اليرموك. ما زلت أذكر تلك الليلة (1998)، حين خرجت من منزلي قرابة الساعة التاسعة قاصداً محلّ بقالة قبالة السور. فوجئت بعناصر أمن عسكري يسدّون الطريق ويطلبون مني العودة. في دقائق، تجمهر عدد من الجيران. علمت (وغيري) أن رجال الأمن طوّقوا المقبرة، وغطّوا سماءها بسواتر من قماش. أحد الجيران نقل عن قريبٍ له، بين العناصر التي طوّقت المقبرة حذّره من الاقتراب أكثر، أنهم يستخرجون رفات جندي إسرائيلي. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وأصبح حديث بيوت المخيّم، لكن صحيفة لبنانية نشرت صبيحة اليوم التالي خبراً مقتضباً مفاده: الأمن السوري ينبش رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد (!) الذي كان حديث وسائل الإعلام في حينه.
أنعشت تلك الحادثة ذاكرة المخيّم، فعادت بأصحابها إلى 1982، حين اخترقت شوارعَ المخيّم دبابةٌ (مغاح 3) إسرائيلية قدمت من لبنان، فوقها جُثَّتا جنديَّين إسرائيليين سار خلفهما أبناء المخيّم مهلّلين هاتفين، ومعها استعادت الذاكرة ما يقال إنه وعيد آرييل شارون لأبناء المخيّم: “لك يوم يا مخيّم اليرموك”.
زخاريا باومل وتسيفي فلدمان ويهودا كاتس، ثلاثة جنود إسرائيليين أُسروا (قتلى أو أحياء) في معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني (10/6/1982)، حين نصبت قوّة من الجيش السوري، تساندها قوات فلسطينية ولبنانية، كميناً محكماً لكتيبتَي دبابات إسرائيليّتَين حاولتا التقدّم لاحتلال طريق بيروت دمشق. انتهت المعركة بهزيمة إسرائيلية موجعة. كان الجنود الثلاثة طاقم الدبابة التي أصبحت واحدةً من غنائم المعركة، وسلّمها النظام السوري لاحقاً للاتحاد السوفيتي لفحصها، بما أنها نسخة معدّلة من الدبابة “M48” الأميركية، ليعيدها فلاديمير بوتين إلى نتنياهو في 2016.
لم تكفّ إسرائيل بحثاً عن رفات جنودها، وأخبرني أصدقاء حوصروا في المخيّم، أنه خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) (2015 – 2018)، وحتّى قبلها بعام، شهدت المقبرة نشاطاً مشبوهاً، واستاء الأهالي غير مرّة ممّا اعتبروه تعدّياً على حرمة الموتى، غير مصدّقين ادّعاءات العناصر المسلّحة بأنهم يبحثون عن أسلحة ومتفجّرات دُفنت في المقبرة، بل اقتحم مجهولون منزل مدير الدائرة السياسية في منظّمة التحرير، أنور عبد الهادي، بحثاً عن تصاميم ومخطّطات هندسية للمقبرة، ورُصدت عمليات تهريب (فردية) لعيّنات من تربة المقبرة إلى خارج المخيّم، مقابل مبالغ مالية. وفي أواسط مارس/ آذار 2019، طوّقت القوات الروسية المخيّم، وتكفّلت وسائلها المتطوّرة طوال أسبوع بما عجزت عنه أدوات داعش البدائية، فأرسلت مجموعة من الرفات إلى إسرائيل لتعثر مَخابرُها على رفات زخاريا باومل.
أعلنت إسرائيل (الأحد) أنها استعادت رفات جثّة تسفي فلدمان بعد عملية خاصّة، في مكان ما بسورية (قالت إنه ليس مخيّم اليرموك)، ومن دون تعاون مع السلطات السورية الجديدة، لكن يبدو أن تلك واحدة من العنتريّات الإسرائيلية، على غرار عملية خاصّة مزعومة لاسترجاع ساعة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين من سورية في 2018، اتّضح أن إسرائيل اشترتها من مزاد في الإنترنت.
ينفي المسار الراهن في سورية فرضية العملية الخاصّة، ويرجّح فرضية الصفقة، بعد أن خطّ الرئيس السوري أحمد الشرع مساراً تفاوضياً مع الاحتلال غير مباشر، ويحتاج التقدّم فيه حتى “التوصّل إلى التهدئة” (بحسب وصف الشرع)، تعاوناً أمنياً، وغيره من خدمات. ولعلّ التحقيق مع الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي (واحد من الرعيل القيادي الفلسطيني القديم، الذي بيده مفاتيح ملفّات فلسطينية كثيرة، ناهيك عن تاريخ من علاقات أمنية وثيقة مع النظام البائد) على صلة بالقضية.
وفي ظلّ تخليه عن المحتجزين الإسرائيليين في غزّة لمصلحة استمرار الحرب، فإن نتنياهو أحوج ما يكون لصفقات مع الشرع، تعيد رفات مَن تبقّى من جنوده في سورية، ولم يكن مفاجئاً أن يصرّح مسؤول أمني إسرائيلي بأن اتصالات جرت مع السوريين لإعادة جثّة الجاسوس إيلي كوهين، والمرجّح أن يستمرّ البحث في سورية عن رفات يهودا كاتس وإيلي كوهين (وربّما أرون أراد؟) بصفقات مضمرة ومعلنة.
———————–
ساعر: إسرائيل مهتمة بعلاقات جيدة مع حكومة دمشق/ عدنان علي
12 مايو 2025
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الأحد، خلال لقاء مع نظيره الألماني المعيّن حديثاً يوهان وادفول، إن إسرائيل مهتمة بعلاقات جيدة مع النظام الجديد في سورية، وهو ما اعتبرته صحيفة “هآرتس” تغييراً حاداً في موقف ساعر، الذي ادعى في شهر مارس/آذار الماضي، في أعقاب اشتباكات عنيفة بين أفراد النظام وأفراد من الطائفة العلوية، أن أفراد النظام الجديد في سورية “كانوا جهاديين ويظلون جهاديين، حتى لو أن بعضهم لبس البدلات”. وجاءت تصريحات ساعر بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، استعادة رفات جندي إسرائيلي من الأراضي السورية كان قد قتل خلال حرب لبنان عام 1982.
وقال ساعر بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “نرغب في علاقات جيدة مع الحكومة السورية، كما نرغب في الاستقرار، لكن لدينا بطبيعة الحال مخاوف أمنية، وهذا أمر مفهوم”. وزعم ساعر أن إسرائيل تحمل “نيات طيبة” تجاه سورية، لكنها تريد الأمن والاستقرار”.
وسبق لوزير خارجية الاحتلال نفسه أن وصف الحكومة الجديدة في سورية بأنها “حكومة إرهابية”. وقال ساعر في فبراير/ شباط الماضي: “أسمع حديثًا عن انتقال للسلطة في سورية، وبالنسبة لي هذا سخيف”، مضيفًا أن الحكومة الجديدة في سورية هي “جماعة إرهابية إسلامية جهادية من إدلب، استولت على دمشق بالقوة. نحن جميعًا سعداء برحيل (بشار) الأسد، لكن يجب أن نكون واقعيين بشأنهم”. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وغيره من المسؤولين السوريين قد قالوا في مناسبات عدة إن سورية لن تشكل تهديدًا لمحيطها.
من جهته، تطرق وادفول، الذي يزور إسرائيل حالياً، إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وانتقدها ضمناً؛ حيث قال إنه “من المهم أن تتمكن البلاد من تشكيل هويتها السياسية من دون تأثير خارجي”. وأضاف أنّ “حماية مختلف المجموعات السكانية يجب أن تكون أولوية للحكومة الجديدة”. وجاءت تصريحاته على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي نفذ الأسبوع الماضي في سورية، بينها الضربة التحذيرية بالقرب من القصر الرئاسي، التي ادعت إسرائيل أنها “رد على هجمات ضد الطائفة الدرزية في ضواحي العاصمة دمشق”.
ورأى المحلل السياسي محمد جزار، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تصريحات ساعر لا يعول عليها، وقد يكون مبعثها محاولة للرد على الانتقادات الإقليمية والدولية المتزايدة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على الأراضي السورية. وأضاف أن إسرائيل تستبيح الأراضي السورية منذ أشهر مستغلة ظروف الحكومة السورية الحالية، ومشكلاتها الداخلية، وعدم حصولها على اعتراف دولي كامل. وتوقع جزار أن تواصل حكومة الاحتلال هذا النهج إلى حين تبلور موقف قوي من جانب حلفاء دمشق في المنطقة، يمكن معه التأثير على موقف الإدارة الأميركية التي وحدها تستطيع لجم انفلات حكومة نتنياهو في المنطقة، وفق قوله.
ومنذ وصول الإدارة الجديدة إلى الحكم في سورية، ترتكب إسرائيل انتهاكات متواصلة للسيادة السورية بذرائع مختلفة، منها استغلال ورقة الأقليات. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس استعادة رفات الجندي في سلاح المدرعات تسيفي فلدمان خلال عملية خاصة في سورية، وذلك بعد 43 عاماً من فقدانه إثر سقوطه في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري إبان اجتياح إسرائيل لبنان عام 1982.
———————-
التحريض الطائفي وخطاب الكراهية.. هل نحن المدانون؟/ جمال الشوفي
2025.05.13
تشهد الساحة الكلامية والخطابية السورية اليوم تزايداً في مؤشرات خطرها على النسيج الوطني. إذ لا يكاد يمضي يوم إلا وعديد الأحداث التي نتابعها ويتفاعل معها رصيد كبير من السوريين بطريقة تنحرف بعيداً عن تضحيات الثورة وعمرها الطويل. فانتشار خطابات التحريض الطائفية المتبادلة واتساع دائرة نفي ولجم المختلف رأياً او قولاً، وازدياد وتكرار معدلات الرفض المطلق والتي تتساوى مع خطاب الكراهية باتت لا تبشر بالخير أبداً، ولربما بكوارث كبرى. فإن كنت أفترض أن انفتاح الفضاء العام أم السوريين بعد قمع متراكم لعقود هو الرائز والمحرك لاستعار حمى الفوضى الثقافية والفكرية والسياسية الذي تعيشها سوريا اليوم كمرحلة أشبه ما تكون بالطبيعية في مراحل ما بعد تغير وسقوط الأنظمة الدكتاتورية كما شهدناها تاريخياً، لكنها بذات الوقت تضعنا جميعاً أمام مسؤوليات واستحقاقات المرحلة الحالية وأخطارها وسبل الإشارة لها وتداركها قبل فوات الأوان.
التحريض الطائفي وخطاب الكراهية هي الوجه الأخطر على النسيج السوري اليوم، وتتجلى أبرز سماته بـ:
– تقسيم الشعب السوري لموال وخائن، خائن وليس معارض! ومن أي الأطراف عامة.
– التعميم الجزافي وتجريم طائفة بأكملها: سنة متطرفون، دروز انفصاليون، علويون فلول….
– تزايد الإشاعات والتضليل الإعلامي خاصة المتداولة على السوشيال ميديا. فإن كانت كثير من الفيديوهات المنشورة صحيحة لكن يقابلها فبركات عديدة غير صحيحة، وهذا مجال للاختلاط والشك بالحقائق.
– تبادل التهم والتكذيب والشتائم واستسهال الإساءة.
– تكفير المختلف سياسياً ودينياً.
– زيادة مؤشرات التقوقع الطائفي.
– انخفاض صوت العقلاء وتهميش أقوالهم، فرغم كل ما يتكلمون به بتهدئة النفوس وتخفيف حدة الغلواء السائدة، لكن مطحنة التحريض والتجريم لا تتح لهذه الأصوات بالسماع…
قد يقول أحدهم وكأنك لا ترى من الكوب إلا نصفه ولا تشير إلا للسلبيات، لأكرر القول إن رؤية الواقع ومعاينته جزء أساسي من الحقيقة أولاً، ومن ثم العلاج ثانياً، فالتشخيص الصحيح جزء من العلاج الصحيح حتى وإن كان صادماً والعكس صحيح أيضاً. فالاكتفاء بالتوصيف السياسي هام لكنه غير كاف اليوم إذ باتت الواقع تتجاوزه للمحتوى والمضمون الثقافي. ما يجعل الوجدان السوري وقيمه الوطنية وتنوعه العام وارتباطه القوي تاريخياً ومصيراً في أهم درجات اختباره اليوم. هو موجود ويحاول جهده نبذ خطاب الكراهية والتحريض الطائفي المقيت، لكن موجة الأخير عالية وجب الوقوف عندها. وقد يقول قائل إنها موجة وإن علت لكنها زائلة ولن تدوم. رغم أني أتمنى ذلك، لكن ما بات يُرقب على مساحة الساحة السورية هو انكشاف لساحة ثقافية دفينة تتجاوز
الفعل السياسي الإجرائي، وهذا الاختبار والتحدي الأكبر. إضافة لذلك، أجد نفسي وأنا أدون هذه الجمل مدان في نفسي وفي ثقافتي، إذ لطالما كنا ولازلنا نحتكم لثقافة المحبة والخير والسلام، وندعو للحوار والانفتاح وتقريب المسافات فكيف وصلنا لهنا؟ ومدان لأنني أكتب عن الكراهية كثقافة وخطاب وهذا خطر كبير أرجو أن أكون مخطئ بتقديره.
أجل، ثمة ثقافة تنتشر كالنار في الحطب، حطب الذات السورية التي لم تستفق بعد من حجم مظلومياتها الثقيلة. فحجم التركة السورية من قتل وعنف وصراع دامي طال البشر والحجر والأطفال وكل صنوف الحياة ليس بالسهولة تجاوزه بنصر سياسي وتغيير سلطة وإسقاط نظام. بل تبدأ النفس البشرية البحث عما يؤمن لها طاقتها من الاستقرار وعنونة الوجود. وما نلاحظه اليوم هو استعار حمى إثبات الوجود بالأحقية المطلقة سواء ممن كانوا مسحوقين من أبناء الثورة وباتوا اليوم منتصرون، ما يجعلهم يستميتون لعدم تقبل أي رأي أو نقد مختلف، أو من الجهات الأخرى التي كانت مسالمة وتعيش في ظل النظام السابق موالية كانت له أو معارضة بصمت، إذ باتت تدافع عن وجودها حين تؤخذ بغرة غيرها بوصفها فلول! في حين المستفيد من هذه المشاهد المتكررة والمتوالية هم الساعون بكل جهودهم التقنية والإعلامية لهدم الاستقرار الممكن في سوريا وهدم تجربة الخلاص من نظام القهر والقمع البائد مولد كل ما نحيا من كوارث. وتقرير الوكالة البريطانية للأخبار (BBC) الذي يكشف أن التحريض الطائفي وبث خطاب الكراهية تقوم به أيادٍ خارجية تسعى لتأزيم الوضع السوري وتفتيته. والمشكلة التي يجب علاجها قبل تفاقهما هو استجابة الشارع الشعبي خلفها سواء بالموافقة الكلية أو الرفض الكلي، ما يجعل غياب العقل والتعقل والتدقيق فيما يقال أو يشاع هو المهيمن على الساحة السورية وسعرات الكراهية وثقافتها بتزايد.
الإشكال البارز في خضم هذه التواترات وما يرافقها من عنف محلي باستخدام السلاج هو تغييب وإدانة صوت العقل وثقافة السلام والبناء. أجل بتنا مدانون من ضفتي خطاب التحريض والكراهية المتبادل، مدانون لكون العاقل منا أراد ويريد مغايرة الواقع والخروج من ثقافة القهر والاعتقال والاضطهاد السياسي ونتائجها الكارثية لثقافة الحوار والعدالة بعيداً عن الانتقام، لثقافة الكلمة بعيداً عن السلاح.
اليوم مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي مسؤولية سورية ثقافية، مسؤولية العقلانية والنخب السورية من جهة، ومسؤولية السلطة واعلامها في الابتعاد عن التحييز والتجيير وكشف الحقائق للعلن بوضوح، ومسؤولية الحكومة بتعدد وظائفها العمل على السلم الأهلي وفتح بوابات الجوار المحلية الأهلية والاجتماعية بين المختلفين في الآراء توصيفاً أو تشكيكاً، وصولاً لحوار الأديان والطوائف على اختلاف عديدها بالجهة المقابلة. وليس فقط بل أيضاً إصدار القوانين لصارمة بمحاسبة كل من يبث خطاب الكراهية والتفرقة الدينية والإساءة للرموز الدينية والتعايش السلمي وفقاً للقانون وبمرجعية القضاء والعدالة، تقليصاً لفكرة الانتقام وتهويناً على الأنفس والحد من الغلو السياسي والديني المتمظهر ثقافياً بسموم الكراهية والتحريض الطائفي.
حملت ثورة السوريين شتى صنوف التغيرات في الواقع المجتمعي والفكري والسياسي، شتى صنوف التناقضات والاختلافات والتباينات! وحتى لا نمارس ذات حكم القيمة السلبية ومحمولها السيء، أدرك أن مسيرة السوريين قد تداخلت في مساراتهم شتى صنوف الجريمة والتي لا يمكن تحميلها لجهة من دون غيرها؛ لكن من حق الجيل الذي عاصر الثورة، جيل القرن الواحد والعشرين وقد بلغ سن الشباب، جيل الانفتاح والتحولات الكبرى من حقه أن نكاشفه بما نحن عليه، بما كنا وكيف صرنا وكيف علينا أن نعمل معاً لتجاوز تحديات الواقع الحالي سياسياً وثقافياً. ولنوصف حينها بجيل الإدانة، لأننا ونحن نعاند مسار الانحدار هذا، علينا تحمل تركات الواقع النفسي والقهري الذي عاشه السوريين ولازال مستمراً لليوم وإن تغيرت المعادلة بين ظالم ومظلوم. ولنكن مدانون حين نقول أن كل السوريون مظلومون ما لم تتحقق العدالة والمساواة وما لم ينصف القضاء جماع المظالم السورية بأهلية القانون واحترام الاختلاف والدفاع عن السلم والسلام والأمان كأساس لبناء دولة الحق والقانون. وهذه مسؤولية جماعية متبادلة بين الحكومة وسلطاتها العامة وبين الشعب وتنويعاتها النفسية والثقافية.
نحن جيل الإدانة وجيل الحرب الذي يخسر به الجميع حتى المنتصر، ووجب علينا المكاشفة، النقد، البحث مرة أخرى في أحقية الوجود واهميته كقيمة جمعية يشارك فيها الجميع في تحقيق قيمة الذات الكلية. والذات الكلية هوية عامة وتعاقد على فعل الوجوب والوجود، أهم ميزاته تحقيق وتقدير الذوات للجميع من دون محاصصة أو خيلاء أو واسطة. ولن نكون ملامون إذا ما تمكنا من تدارك الانحدار الذي نعيشه وعلاج تركة الخيبات والآلام والحسرات وعدم تكرارها مرة أخرى.
لم أرغب بالدخول بتحليل سياسي في هذا الصدد إلا لأنني أتلمس ضعفه أمام الإشارة للواقع الثقافي السائد وأخطاره الجسام، ولأكن مدان بهذا أيضاً، فسوريا التي نريد وإن كانت بوابة ولوجها سياسية لكن افتراش واقعها وحياتها ثقافية واسعة تحتاج العناية والاشارة والدلالة.
تلفزيون سوريا
——————————
فلول في ثياب الأمن العام.. من يفكك الألغام الاجتماعية من مخلفات الأسد؟/ عبد القادر المنلا
2025.05.13
بعد هروب بشار الأسد، اعتقد السوريون أن تلك الصفحة السوداء في تاريخ سوريا قد طويت إلى الأبد، وأن سوريا الجديدة قد بدأت تلملم جراحها وتكنس تاريخ تلك العائلة التي دمرت سوريا وشوهت نسيجها الوطني، تلك المرحلة الطويلة التي ابتدأت مع تسلط الأب على السلطة، ولم تنته إلا بعد أن أكمل الابن تدمير سوريا وتمزيقها..
وبعد أقل من شهر على التحرير، اكتشف السوريون مخلفات الأسد التي اتضح أن تنظيفها يحتاج لفترة أطول مما كان متوقعاً، فبالإضافة إلى كميات الدمار والخراب والانتهاكات الجسيمة والمجازر الجماعية والمعوقين والمعتقلات وما كان يحدث فيها وملايين المهجرين وسرقة مقدرات البلد وحجم الفقر والحاجة الذي وضع فيه النظام السابق السوريين قبل وبعد رحيله، فلقد تم اكتشاف كمية كبيرة جداً من الألغام المنتشرة في كل مكان في سوريا، ولكن تلك الألغام لا تتوقف عند الألغام الأرضية المادية المتعارف عليها، فثمة نوع آخر أشد خطراً وفتكاً بالمجتمع السوري وهو الألغام الفكرية والاجتماعية والمتمثلة في الزراعة المتعمدة للطائفية وهي الألغام التي بدأت تنفجر تباعاً وتضع السوريين في مواجهة خطر قد يقضي على حلمهم في بناء دولتهم الجديدة.
بدأت أول تلك الألغام تتفجر بظهور الفلول التي قامت بعمليات لم تستهدف الأمن العام فقط ولا حلم السوريين وحسب، بل استهدفت بالدرجة الأولى الطائفة العلوية التي كان معظم أبنائها متوافقين مع سوريا الجديدة وفرحين بالتخلص من الأسد مثلهم مثل باقي المكونات السورية، راهن الفلول على رد فعل الدولة الطبيعي والذي تمثل في حملة عسكرية مضادة انفلتت في بعض الأحيان لتتحول إلى حالة انتقام من أبناء الطائفة، وهو بالضبط ما كان هدف الفلول للتأسيس لمرحلة من الفوضى وإثبات الاتهامات على الدولة الجديدة على أنها تستهدف طائفة محددة، الأمر الذي أنهى شهر العسل الذي عاشه الساحل السوري، وأدى إلى تهديد السلم الأهلي والذي يكاد اليوم أن يتبدد إن لم يتم التعامل معه بشكل احترافي وموضوعي ونزع تلك الألغام سريعاً..
ورغم أن الجرائم التي ارتكبت ضد الأبرياء والانتهاكات التي حدثت في الساحل تم نسبها إلى فصائل متشددة، وأفراد خارجين على القانون، إلا أن ذلك لا ينفي مشاركة الفلول فيها سواء بالمشاركة الفعلية أو من خلال التسبب فيها، غير أن كثير من الروايات التي تواردت -وهذه لا يمكن إثباتها أو نفيها حتى الآن- تؤكد مساهمة الفلول في قتل أبرياء من الطائفة العلوية ونسبها إلى تلك الفصائل للمساهمة في زيادة صب الزيت على النار، ثم تطورت آليات عمل الفلول حيث راحوا يرتدون ملابس الأمن العام ويرتكبون المجازر، وهو ما يؤكده قتل شخصيات علوية كانت معروفة بمعارضتها لنظام الأسد حيث تضرب الفلول عصفورين بحجر من خلال ارتكاب تلك الجرائم، أولها الانتقام من معارضي الأسد من الطائفة العلوية، وثانيها اتهام الدولة بهم، لأن تلك الطريقة وحدها هي ما يضمن تأليب السوريين ضد القيادة الجديدة ولا سيما أن الطابع الديني والمتطرف أحياناً الذي أبدته بعض الفصائل سيسهم بشكل كبير في إقناع الرأي العام المحلي والدولي بصحة نسبة تلك الانتهاكات إلى الدولة..
هذا لا ينفي بالتأكيد الجرائم التي ارتكبها أفراد وفصائل محسوبون على الحكومة الجديدة وعلى الأمن العام ووزارة الدفاع، ولكن الفلول اتبعت أيضاً ذات طريقة النظام البائد وأساليبه الشيطانية في معالجة أزماته، ففي بداية الثورة السورية وقبل أن يحمل أحد من السوريين السلاح لم يتردد نظام الأسد بقتل كثير من عناصره وجنوده وحتى بعض ضباطه، ليثبت أن ما كان يحدث ليس ثورة وإنما عمليات إجرامية تقوم بها مجموعات مسلحة إرهابية تقتل الأبرياء، وتبدو الفلول اليوم بحاجة لذات الذرائع التي اعتمدها النظام لتشويه الثورة حينها لكي تتمكن من تشويه صورة الحكومة الجديدة اليوم، فعقلية الفلول لا تختلف عن عقلية نظامهم وقدراتهم الإجرامية لا تقل عن قدراته ومستوى الانحطاط الأخلاقي لديهم لا يقل عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لنظامهم البائد، بل ربما تفوقوا عليه في الانحطاط بعد أن فقدوا السلطة وفقدوا أيضاً بوصلتهم الإجرامية التي كانت تستهدف المعارضين للأسد بشكل رئيسي وأضحت اليوم ترتكب الجرائم بشكل عشوائي ولا تتردد في قتل أفراد من الطائفة العلوية، فبهذه الطريقة وحدها تضمن إزعاج الحكومة الحالية وقضّ مضاجعها واستدراجها إلى موقع الدفاع عن النفس..
ومع الإقرار باحتمالات قابلية كل ما سبق ليكون حقيقة، إلا أنه ليس الحقيقة الوحيدة، فثمة اليوم فئات عديدة من الفلول الذين يعملون لصالح الأسد الفارّ من دون قصد، وربما يعتقدون أنهم يعملون لصالح الحكومة السورية ولصالح الدولة، وأول هؤلاء هم العناصر المحسوبة على الدولة الجديدة والتي ترتكب جرائم قتل بحق الأبرياء من الطوائف الأخرى ظناً منها أنها تسهم في بناء الدولة من خلال التخلص من أفراد لا ينتمون لذات العقيدة التي ينتمون هم لها، وهي أكبر خدمة تقدم للفلول وللمتربصين من الحريصين على عرقلة مسار الدولة السورية وإفشالها، أو أولئك الذين يجرّمون طائفة كاملة فقط لكون الأسد ينتسب إليها وهؤلاء يقومون بالقتل وكأنه فعل وطني، وهذا سلوك لا يختلف عن سلوك الفلول في شيء لا من حيث الفعل نفسه ولا من حيث النتائج المترتبة عليه..
في ذات السياق، يلعب كثيرون من مؤيدي الحكومة الجديدة دوراً لا يقل عن دور الفلول في تنزيههم للفصائل التي ترتكب الانتهاكات وإنكارهم لأي خطأ ترتكبه الحكومة بل وتحويله إلى فضائل، سواء كان ذلك بسبب الانتماء الطائفي أو بسبب الحماس الزائد للدولة الجديدة وحكومتها أو بسبب الجهل والتشدد، وهي ذات طريقة أتباع النظام السابق في تقديسهم للأسد وإنكار جرائمه، في حين إن مساعدة الحكومة الجديدة والوقوف إلى جانبها في سعيها لبناء الدولة يتطلب الاعتراف بأخطائها والحرص على نقدها وعدم تبرير أي خطأ يتم ارتكابه لأن ذلك سيؤدي إلى تراكم الغش والخديعة وتوسيع الهوة بين مكونات الشعب السوري والتي تحاول الحكومة أن ترممها، على الأقل في حين يتعلق بالموقف الرسمي والتصريحات العلنية..
النوع الآخر من الفلول يتمثل في أولئك الداعمين للإشاعات والذين تهمهم الشائعة أكثر مما تهمهم الحقائق، وهؤلاء موجودون في كل المكونات، حيث تلتقي الشائعة مع رغباتهم فيسعون بكل طاقتهم إلى نفي الحقائق وإحلال الشائعات مكانها حتى لو تم دحض الشائعة، وهؤلاء يدعمون مشروع الفلول بقوة بل ويتحولون إلى جزء منه في حين هم يعتقدون أنهم يحاربون ذلك المشروع..
منذ أيام أصدر مفتي سوريا فتوى بتحريم الدم السوري، وبالأمس صدر قرار هام للغاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتجريم كل الأصوات التي تحرض على الكراهية ومساءلة أصحابها مدنياً وجزائياً وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وهي خطوات على طريق لجم الطائفية المستشرية والحد منها، ولكن المعركة لا تزال طويلة ومعقدة لأن الدمار النفسي والاجتماعي الذي خلفه نظام الأسد لا يزال يتحكم بكثيرين من أبناء الشعب السوري من كافة الطوائف والمكونات، وهنا تبدو المراهنة على نشر الوعي هي الطريق الأمثل لحماية الشعب السوري من سرطان الكراهية وأمراض الطائفية الخبيثة..
لقد آن الأوان لتفعيل القوة الناعمة، وهي قوة الثقافة والتي لا تزال حتى الآن شبه معطلة نظراً للمخاض العسير الذي تمر به البلاد، غير أن الالتفات إلى قوة الفعل الثقافي وقدرته على المساهمة في ترميم المرحلة يبدو اليوم من أهم الأسلحة وأكثرها فاعلية، وهنا يمكن استغلال المسارح والمراكز الثقافية لإقامة نشاطات وفعاليات أدبية وفنية وفكرية تنشر مفهوم المواطنة وتضعه فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهو طريق أساسي ممهد ويساعد بشكل استثنائي في الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد، والخروج من دوامة الإشاعات أيضاً، كما أنه الضامن لمشروع السلم الأهلي وأحد مرتكزاته الأساسية والذي لا يمكن أن يتحقق من خلال لجان تحقيق في الجرائم فقط، ولا في قوانين معينة، بل في نشر الوعي الذي يحتاجه المجتمع السوري ليتمكن من استئصال الأمراض المزمنة، ونزع الألغام الاجتماعية التي تركها الأسد على امتداد الأرض السورية، وبغير ذلك سيبقى من السهل على الفلول من كل الأنواع السابقة التي تم ذكرها ارتداء ملابس الأمن العام، وستبقى قدرات الشائعات أكبر من قدرات الحقائق..
تلفزيون سوريا
———————————–
“لا نتدخل ولا نؤثر”.. موفق طريف يعلن وقف تدخلاته ويدعو لسوريا موحدة
2025.05.13
أعلن الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في فلسطين، الشيخ موفق طريف، وقف أيّ تدخل أو تأثير في القرارات الداخلية للطائفة الدرزية في سوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وهويتها الوطنية.
وقال طريف في بيان رسمي، إنه على تواصل مستمر مع مشايخ الطائفة في سوريا لـ”الاطمئنان على أحوالهم وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع، دون التدخل في رؤيتهم أو التأثير على قراراتهم الداخلية”، آملاً أن تتجه الأمور نحو “الحلول المرجوة”.
وجدّد التزامه بمساندة أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، مضيفاً أن موقفه هذا ثابت منذ سنوات الأزمة السورية، وينبع من منطلق “التمسك بقيمة حفظ الإخوان”، دون التدخل في “القضايا الاستراتيجية، كونها من شأن الطائفة في سوريا”.
وشدد على ضرورة حفاظ الطائفة الدرزية في سوريا على هويتها ومكانتها داخل الوطن الموحّد، مضيفاً: “نقرّ أنهم أصحاب القضية وأهل الدار، وهم أولى بمصلحتهم وأعلم من الجميع بأولوياتهم وقراراتهم”.
نساند دروز سوريا ونحذر من الفتن والإشاعات
ذكّر طريف بدعوات سابقة وجّهها إلى جميع مكونات المجتمع السوري، داعياً إلى “الحفاظ على الحقوق الدستورية، والتوجّه نحو الحوار كوسيلة للنهوض بسوريا لمصلحة جميع مواطنيها ومناطقها دون إقصاء أو استثناء، وعلى وجه الخصوص الطائفة الدرزية التي كان لها دور بارز في تاريخ البلاد”.
كما دعا طريف جميع السوريين إلى العمل معاً لإعادة إعمار سوريا والنهوض بها، محذراً من “أيادي الإرهاب الطويلة التي تحاول دق الأسافين والعبث في النسيج الاجتماعي السوري”.
وفي سياق آخر، أشار إلى خطورة المعلومات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التصريحات الوهمية والشائعات، مطالباً بالتعامل معها بحذر ومسؤولية، و”الامتناع عن أخذ المواقف والأقوال الصادرة عن شخصيات ومصادر غير رسمية، أو عن أفراد لا يمثلون الطائفة ومؤسساتها دينياً ومجتمعياً”.
وأوضح أن موقف طائفة الدروز في فلسطين يتمثل في دعم ومساندة الطائفة في سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مواصلة الدعوة للوحدة وتوحيد الصفوف في وجه التحديات.
يُشار إلى أن طريف التقى خلال الفترة الماضية مع مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة طلب الحماية للطائفة الدرزية في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقتا جرمانا وصحنايا.
———————–
نعمة الطوائف ونقمة الطائفية: في العقد الاجتماعي وقلق الهوية السورية/ محمد خالد شاكر
13 مايو 2025
لم يشهد التاريخ السوري فرزاً دوغمائياً نكائياً طائفياً أكثر مما يشهده اليوم؛ فلم تعد الطائفية في سورية خطاباً شعبوياً على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بقدر ما تحولت إلى حالة مرعبة، أصبحت تتسلّل رويداً رويداً إلى الخطاب السوري، إعلامياً، وثقافياً، وسياسياً.
قبل تأصيل ظاهرة تصاعد الخطاب الطائفي بسبب عدم تبلور الهوية السورية، تاريخياً، في إطار عقد اجتماعي يعكس تعدّدية المجتمع؛ لابد من التعريج على أسبابه المباشرة التي ولدت من رحم صراع دموي ومدمّر، فالتحوّلات القسرية التي طرأت على المجتمع السوري خلال سنوات الحرب 2012- 2024، دفعت بالشخصية السورية المذعورة إلى الانكفاء على خصوصيّتها ردّ فعل للواقع المحتدم؛ فتحول المجتمع السوري المسالم والمتآلف إلى خاصرة رخوة من الخوف والانقسام والتشظي طائفياً، وإثنياً، ومذهبياً، وسياسياً، وعسكرياً.
وكما تفرض التعدّدية السياسية نفسها ميزة لتعزيز قيم العدالة والحكم الرشيد في مواجهة الاستبداد، تشكل المجتمعات المتعددة طائفياً وإثنياً إحدى ميزات المجتمعات المتحضرة اليوم، وذلك من خلال حوكمة مؤسّساتها، التي تضطلع بصهر الهويات الفرعية في بوتقة الدولة الوطنية، فكلما أحسنت السلطات الحاكمة إدارة التنوّع والاختلاف، نجحت في إدارة التنوّع ونقلته من تعدّدية الصراع إلى تعددية التوازن والتكامل.
تواجه المؤسّسة الثقافية السورية اليوم المهمّة الأكثر إلحاحاً في طريق بناء الدولة السورية، وذلك في قدرتها على مواجهة الخطاب الطائفي الشعبوي المنفلت، وانتشال العقلية السورية من إرثها الثقيل المحمّل بعقود من القهر والخوف والموت والاستبداد.
لقد أصبحت الطائفية وجبة شهية مادتها الكراهية والتشفي والانتقام، فطفت على السطح مفردات الضد من الوطنية، كتسفيه الاعتقاد والخصوصية الدينية، والحديث عن تاريخية هذه الطائفة، وغموض تلك، ووصف هذه الطائفة بالغلو والكفر؛ يؤازرها سرديات لي عنق التاريخ من خلال الحديث عن علاقة هذه الطائفة بالمحتل الفرنسي، وربط تلك الطائفة بالنظام البائد، والأخرى بإسرائيل، قابله انكفاء على الخصوصية، أدّى إلى تصاعد حمّى الهويات الفرعية؛ وكأن السوريين يتجهزون لمرحلة ملوك الطوائف، في مرحلة أحوج ما يكونون فيها إلى وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة السورية، وبلورة هويتها الوطنية الجامعة.
يرى جان جاك روسو ( 1712- 1778) “أن البشر مسالمون بطبيعتهم، لكن القوانين والمؤسّسات هي التي تفسدهم” في إشارة إلى طبيعة العقد الاجتماعي أو الدستور الذي يحكم الأفراد والجماعات، وبالأدق قدرة السلطة والقوانين على إيجاد آلية للالتزامات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، بوصفها علاقة جدلية تؤدّي، في نهاية المطاف، إلى تحقيق الإرادة العامة، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، فلا دولة بدون سيادة، ولا سيادة بدون إرادة عامة مشتركة، ولا إرادة عامة بدون عقد اجتماعي يعكس تطلعات الجميع.
أدّت التطورات التاريخية لفكرة الدولة بعد مؤتمر وستفاليا (1648) إلى إنهاء الحروب الدينية في أوروبا، وحل المشكلة الطائفية. كما أدّت التطورات التاريخية لمفهوم الديمقراطية والهزات التي عانتها أوروبا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الانتقال من فكرة الدولة القومية إلى دولة المواطنة حلّاً لإشكاليات الهويات الفرعية وصراعاتها، فأصبح الفرد وبغض النظر عن خصوصيته مواطناً له الحق في أن يكون له وطنٌ، لا يعيش فيه فحسب، وإنما يشارك في بنائه.
أسّست فكرة المواطنة لتدوين الحقوق الطبيعية، أو ما يسميها بالمفهوم الإيكولوجي عالم العقائد توماس بيري ( 1914- 2009) بـ “شريعة الأرض”، أي الحقوق التي تولد مع الإنسان وفي بيئته، ومنها الحقّ في الحياة والوجود، والحقّ في الحرية، والحق في التعبير، والحقّ في الكرامة، والحق في الملكية، بوصفها حقوقاً متأصلة في النفس البشرية وموجودة في مراحل ما قبل الدولة، ومن ثم، لا يحقّ لأية سلطة مصادرتها أو النيْل منها.
عرفت سورية أولى إرهاصات تشكيل الهوية الوطنية خلال فترة الحكم العثماني، عندما أسّس بطرس البستاني ( 1819- 1883) صحيفة “نفير سورية” أول صحيفة وطنية، كما أسّس “المدرسة الوطنية العليا” التي ضمّت طلاباً من جميع الطوائف.
منذ تأسيس الدولة 1920، لم تشهد سورية أي حراك جماهيري يعكس الممارسة الفعلية لديمقراطية قادرة على بلورة هوية سورية نابعة من فكرة سيادة الشعب. ولهذا، لم تعرف سورية حكومة وطنية بشرعية شعبية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فقد كانت غالبية الحكومات السورية نتاج تحالفات كولونيالية. على سبيل المثال، ضمّت الوزارة الأولى بعد إعلان الاستقلال في مارس/ آذار 1920 مجموعتين، هما مجموعتا رضا باشا الركابي الموالي للإنكليز وعلاء الدين الدروبي الموالي للفرنسيين، تزامن ذلك مع تشكيل برلمانات بديمقراطية هشّة، أوصلت المتنفذين، والباشوات، والإقطاعيين، والتجار، وشيوخ العشائر من جميع الطوائف والإثنيات.
طوال فترة الاحتلال الفرنسي، استمر استنساخ الأزمة البنيوية للهوية السورية نتاجاً كولونيالياً، فتشكّلت هوية سياسية نخبوية هي الأخرى من تجّار المدن، وكبار ضباط الجيش العثماني السابقين، والإقطاعيين، وشيوخ القبائل، والأشراف، ورجال الدين، والوجهاء، بصفتها تركيبة غير متجانسة هوياتياً بالمعنى الوطني، تجمعها، أفقياً، المصالح وتقاسم السلطة، بينما تغيب، عمودياً، الجماهير السورية؛ في دولةٍ صُممتْ بالأساس بطريقة استعمارية، بحيث يصعب على أية دولة خارجية الانتصار فيها وحدها، كما يصعب على أي طرف سوري الاستئثار بها داخلياً. وهو ما يفسّر بقاءها محكومة بثنائية الانقلابات والاستبداد، كما هشاشتها في مواجهة التحديات الخارجية، بسبب متواليات القضم الجغرافي من أجزائها منذ الاستقلال.
مع انقلاب 1970 الذي أسس للمرحلة الأسدية 1970- 2024 جرى من جديد، وبطريقة ما، استنساخ التحالف الكولونيالي ذاته للهوية السورية، بوصف ذلك تركيبة جاهزة للاستئثار بالسلطة، حيث عقدت السلطة في مرحلة الأسد الأب وابنه تحالفاتها مع كبار التجار في تزاوج خبيث بين المال والسلطة، كما أعادت صياغة المشيخة من داخلها على أسس ولائية، وأفرغت العقيدة العسكرية للجيش واستبدلتها بالأجهزة الأمنية؛ فتحوّلت سورية إلى دولة عسكرتارية شمولية، تئن فيها جميع الطوائف والإثنيات تحت وطأة الولاء للسلطة، الذي نقل الهوية السورية من مرحلة القلق إلى الإلغاء، فعاشت سورية حكماً بوليسياً يخفي تحت رماده، جمر الصراعات البينية سياسياً، وطبقياً، ومناطقياً، وطائفياً، وعشائرياً، وهي التصدّعات التي أسّست في مراحل لاحقة لانفجار مجتمعات المخاطر في مارس/ آذار 2011.
أدّى تحوّل الثورة السورية إلى صراع طائفي مخيف وبدفع خارجي إلى تصاعد الهويات الفرعية السورية، وبالأخص المذهبية منها، ما دفعها إلى الانكفاء على خصوصيتها حالة طبيعية في النفس البشرية خلال الأزمات. وتصاعدت المسألة الطائفية أكثر مع سقوط النظام، خصوصاً مع رفض آليات إدارة المرحلة الانتقالية، التي رأت فيها باقي الطوائف وبعض الكرد، وكثير من النخب السنية، استئثاراً لسلطة دينية سنّية بعينها، تجافي تطلعات السوريين في التشاركية والمواطنة. وهو الموقف الذي يأخذ بالتزايد بين السوريين يوماً بعد، خصوصاً بين قوى المعارضة من السياسيين والعسكريين والمدنيين المنشقين عن النظام، الذين بدؤوا يشعرون بأنهم فئة غير مرغوب فيها في عقلية الحكم الجديد، ما يضع سورية أمام حالة من اتساع دوائر الانقسام السوري طائفياً، وإثنياً، وسياسياً.
يقف السوريون اليوم أمام استحقاقٍ أخير مهم ومفصلي، متمثلاً في الهيئة التشريعية ولجنة صياغة الدستور في مرحلة قلقة وهشّة يقف فيها الجميع أمام خطر وجودي؛ ولحظة تاريخية يجدُر بهم اقتناصها لإعادة صياغة هويتهم السورية من خلال البحث عن مشتركاتهم التاريخية، بدءاً من الأخذ بنعمة التعدّدية في المجتمعات المتحضرة، والتوجه إلى ما هو جامع. فهم عرب من مسيحيين وعلويين ودروز وسنة، وهم مسلمون من كرد وعرب.
سورية اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى دستور عصري يؤطّر الهوية السورية، ويصوغ عقدها الاجتماعي في إطار دولة المواطنة، الكفيلة وحدها بإبعاد غول الطائفية الذي يطلّ برأسه على جميع السوريين، وفي أضعف حالاتهم من الجوع، والخوف، والدمار، والانقسام. وهي المهمّة التي تبدأ من ثورة ثقافية بخطاب سوري جامع، يطفئ نار النكايات الطائفية قبل أن يكتوي بها جميع السوريين.
العربي الجديد،
——————————
توترات طائفيّة في الجامعات السوريّة: الوجه القبيح لزملاء الدراسة!/ عمر الهادي – مدون سوري
13.05.2025
لطالما شكلت الجامعات فضاء يجمع الشبان والشابات السوريين من مختلف الخلفيات، ورغم هشاشة البنية التحتية لهذه المؤسسات، إلا أنها استطاعت خلط السوريين ودفعهم الى التعارف، ومن ساحات هذه الجامعات، خرج عدد من التظاهرات ضد النظام، قمعت بوحشيّة حينها، لتعود الآن الجامعات إلى طلابها، لكن يخشى اليوم أن يتحول السكن الجامعي إلى مساحة غير آمنة ومشحونة بالخوف.
شهدت جامعات سورية في الأسبوعين الماضيين، تصاعداً في حدة التوترات الطائفيّة بين طلاب المحافظات، توترات وصلت حد التهديد والاعتداء الجسدي وهتافات وصلت الى الاحتفاء بـ”إبادة” الأقليات الدينية. أفضت هذه التوترات الى ترك الكثير من طلاب السويداء المدن الجامعية في حلب، حماة، حمص، ودمشق، وعادوا إلى محافظتهم، خشية اندلاع مواجهات طائفية جديدة، في ظل تراخٍ أمني لضبط هذه الحاضنات الطلابية.
تمكنا في “درج” من التواصل مع عدد من الطلاب في مختلف الجامعات السورية، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، لسرد شهاداتهم حول الأحداث التي شهدوها.
هل أضحت الجامعات ساحات للترهيب؟
لم يكن خروج طلاب السويداء من السكن الجامعي قراراً فردياً، بل جاء كرد فعل جماعي في سياق تصعيد مستمر، خروج جماعي كشف عنه مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عشرات الطلاب أثناء مغادرتهم المدينة الجامعية في دمشق.
أثار الفيديو جدلاً واسعاً حين انتشر، إذ وصفه البعض بـ”التغريبة الجامعية”، فقرر عدد من الطلاب المغادرة يوم 29 نيسان/ أبريل، بعدما تعرضوا لمضايقات طائفية تراوحت بين التهديد والاصطدام اللفظي والجسدي، أودى بعضها إلى إصابات.
بدأت الأحداث في المدينة الجامعية بحمص عقب انتشار تسجيل صوتي “مفبرك” حمل إساءة دينية، نُسب إلى أحد شيوخ السويداء، ما أدى إلى حالة من التجييش، تجسدت في تجمعات داخل السكن الجامعي، رددت تهديدات مباشرة بحق الطلاب الدروز، بينها: “كل واحد درزي منشوفوا بالسكن ذابحينوا”، وسط هتافات وتكبير.
تصاعد الأمر إلى اقتحام غرف الطلاب الدروز والاعتداء عليهم بالعصي والجنازير، إذ تعرض الطالب (م.ش)، وهو طالب هندسة بترول في السنة ثالثة، لهجوم عنيف داخل غرفته، أصيب خلاله بجروح خطيرة في الرأس، إلى جانب الاعتداء على زملائه.
في حلب، تكرر السيناريو ذاته، إذ تعرض الطالب (أ.غ)، وهو طالب هندسة ميكانيكية في السنة الثالثة، للطعن بالسكين في صدره وساعده وظهره لأنه درزي.
تقاطعت شهادات طلاب عدة حول تلقيهم تهديدات منذ بداية أحداث الساحل، عبر رسائل إلكترونية وملاسنات لفظية، إضافة إلى تجمعات شهدت أحاديث علنية عن “النصارى” وغير المسلمين. وقد حصل موقع “درج” على محادثة من إحدى الطالبات، خلال نقاشها مع صديقها حول أسباب هذا التغير المفاجئ، ليجيب: “هلق صارت طائفية، أي درزي بدنا نشوفو بالسكن رح نقتلو، يلي مو عاجبو ينقلع ع السويدا”.
وبحسب ما ورد في رواياتهم، تدخل الأمن العام لفض الاشتباكات وحماية الطلاب، لكنه لم يضبط التظاهرات التي واصلت التحريض ضد طلاب السويداء.
أما في حماة، فتروي ماري (اسم مستعار)، طالبة طب أسنان، تجربتها قائلة: “خرجت مظاهرة في ساحة العاصي يوم 28 نيسان/ أبريل، حملت شعارات (سنية سنية، بدنا نبيد الدرزية)، ثم انتقل التجمع إلى المدينة الجامعية، بمشاركة أشخاص من خارج السكن، وسط انتشار واضح للسلاح”.
تكمل ماري: “في اليوم التالي، توجهنا إلى الكلية لإنهاء إجراءات الاستضافة في دمشق وجمع أغراضنا، وخلال ذلك، مرّ شابان بجانبي وقالا (سبحان من أعزنا وأذلكم)، رغم أنني لم أتعامل معهم طوال سنوات دراستي. وبعد يوم كامل من توقيع الأوراق، فوجئنا برفض الطلبات بحجة الحاجة إلى موافقة من دمشق، رغم أن آخر مهلة للتقديم كانت الأربعاء الماضي”.
تأتي هذه الشهادات رداً على إنكار الإعلام حقيقة المضايقات التي تعرض لها طلاب السويداء، ما ساهم في تجاهل السلوك العدائي وتصعيده عند البعض بدلاً من الحد منه.
لطالما شكلت الجامعات فضاء يجمع الشبان والشابات السوريين من مختلف الخلفيات، ورغم هشاشة البنية التحتية لهذه المؤسسات، إلا أنها استطاعت خلط السوريين ودفعهم الى التعارف، ومن ساحات هذه الجامعات، خرج عدد من التظاهرات ضد النظام، قمعت بوحشيّة حينها، لتعود الآن الجامعات إلى طلابها، لكن يخشى اليوم أن يتحول السكن الجامعي إلى مساحة غير آمنة ومشحونة بالخوف.
تروي سارة (اسم مستعار) طالبة الصيدلة سنة رابعة، تجربتها في السكن الجامعي بالمزة قائلة: “بعد الأحداث التي استهدفت الطلاب الدروز في حمص، بدأ قلقنا يتزايد، لكننا واصلنا الدوام، وبينما كنا نجلس مع الأصدقاء في الحديقة مساء يوم الاثنين، بدأنا بسماع تكبيرات تتردد، وسرعان ما احتشد الطلاب وهم يكررون الهتافات، قبل أن تدخل سيارة للأمن العام، وأثناء صعودنا نحو الغرف، سمعت أحد المتجمعين يقول (رح يشوفوا آخرتن هالخنازير)، في إشارة واضحة إلينا، عندها بدأنا بتوضيب أغراضنا استعداداً للرحيل”.
في سكن الهمك (كلية الهندسة الميكانيكيّة)، قوبل هذا التجمع باحتشاد مماثل، وتعددت الروايات حول أسباب التصعيد. إذ أشارت شهادات إلى أن الحادثة بدأت بعد العثور على كتاب ديني قرب إحدى حاويات القمامة، كادعاء ضد أحد الطلاب الدروز، بينما أكدت شهادات أخرى أن الخبر مجرد إشاعة استُخدمت لتأجيج التوترات.
تضيف طالبة أخرى من كلية الإعلام سنة ثانية: “شاهدت طلاباً يضعون على جباههم رايات تحمل عبارة لا إله إلا الله، في اللحظة التي بدأت فيها التكبيرات تتصاعد”.
في هذا السياق، تُلصق تهمة “العمالة لإسرائيل” في الحوارات كتبرير للإقصاء والعدائية، إذ تُستخدم لصنع “عدو افتراضي”، ما يفتح الباب أمام استهداف الدروز على مستويات متعددة، بدءاً من التشكيك في انتمائهم الوطني، وصولاً إلى محو دورهم في الثورة السورية، وتدنيس رموزهم الدينية والتاريخية من البعض.
ما حدث مع طلاب السويداء كان امتداداً لمضايقات طاولت سابقاً طلاب الساحل، وسمح تأخر الإجراءات الحاسمة بانتشار السلوكيات الطائفية والتهديد علناً، إذ لم يُضبط الخطاب التحريضي بفعالية، وبينما كان يُتوقع إصدار بيان يجرم هذه الاعتداءات، جاء بيان وزارة الداخلية مشيداً بـ”غيرة المواطنين”، رغم طابعها العدائي، ما أثار تساؤلات حول حيادية المؤسسات الرسمية.
تحوّلات الحدث في الإعلام
بعد مغادرة طلاب السويداء السكن الجامعي، سارعت وسائل إعلام رسمية إلى تقديم روايات نفت فيها تعرض الطلاب لأي ضغوط، وزعم ناشطون إعلاميون أن الإجلاء تم بتوجيهات من شيوخ السويداء، وهو ما نفاه الطلاب مؤكدين أنهم غادروا لدرء الاستفزازات التي بدأت تأخذ منحى مشابهاً لما حدث في حمص وحلب، بعد محاولات لامتصاص المناكزات الفردية التي تعرضوا لها.
تصوير الواقع الجامعي كبيئة آمنة لم يكن مجرد انفصال عن الواقع، بل إنكار لما تعرض له طلاب السويداء، يلاحظ اليوم اتباع بعض الإعلاميين نهجا مكرراً في التعامل مع القضايا المثيرة، إذ يتم تجاهل جوهر المشكلة، وبدلاً من فتح باب الحوار حولها لمعالجتها، يتم لوي الخبر وإعادة تشكيله وفق سردية تخدم توجهات معينة.
وفي مواجهة هذا التشكيك، أصدرت مجموعة من طلاب السويداء بياناًً رسمياً في 8 أيار/ مايو، أكدوا فيه رفضهم للفتنة الطائفية، وتمسكهم بالوحدة الوطنية، مشددين على أن انسحابهم من الجامعات كان قراراً ذاتياً، كما طالبوا بتجريم الخطاب الطائفي، وتأمين الحماية اللازمة للطلبة، ومحاسبة المحرضين والمعتدين.
وجاء الرد على هذا البيان عقب اجتماع عقد يوم السبت 10 أيار/ مايو في دمشق، جمع وفداً أهلياً وسياسياً من محافظة السويداء بوزيري الداخلية والتعليم العالي، وأسفر هذا الاجتماع عن قرار صدر عن وزارة التعليم العالي في سوريا، ينص على: “حظر نشر أو تداول أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية، مع فرض مساءلة جزائية على المخالفين”.
ورغم اعتبار هذا القرار خطوة مهمة وجادة نحو معالجة الخطاب الطائفي، إلا أنه عكس تحولاً في التعامل مع القضية، من الإنكار في البداية إلى التجريم لاحقاً! ما يفتح المجال لمراجعة أعمق حول آليات عمل المؤسسات التعليمية والإعلامية، وضمان بيئة أكثر أماناً وتماسكاً لجميع الطلاب.
ظهر أيضاً بيان باسم “حراك طلابي” هدفه “جامعة خالية من العنف والسلاح، ومنحازة الى عدالة والكرامة والحرية للجميع”، رافعاً شعارات “فكر تضامن مساواة”، البيان ذو لغة واعدة غير معروفة أسماء الموقعين عليه أو من صاغوه سوى بأنهم “طلاب وطالبات من جامعات سوريا”، هكذا حراك وبيانات مهم في هذه المرحلة لكن من دون ترجمة على الأرض وداخل الحرم الجامعي، يبقى مجرد نداء في المجهول، خصوصاً أمام محاولات إعادة تعريف الفضاء الجامعي إما عبر مبادرات الأسلمة، أو الاحتشاد الطائفيّ كما حصل سابقاً.
درج
—————————–
حرائق الطائفية في سوريا تشتعل من جديد وسط صمت العدالة/ دانيالا ويلسن
12.05.2025
القلق منتشر بشكل خاصّ بين الطلاب الدروز في دمشق، وفي حمص، وحتى في اللاذقية، بعد أن سُجّلت هتافات طائفية وتهديدات ضدّهم داخل الجامعات ومساكن الطلّاب، تقول الطبيبة الشابة:”شاركت في مظاهرة في ساحة الأمويين عندما سقط النظام، يبدو ذلك وكأنه زمن بعيد”.
في بلدة الصورة الكبيرة الدرزية الصغيرة الواقعة على مدخل محافظة السويداء من جهة دمشق، يلوح مقام الخضر الديني متفحّماً. الهواء مُشبع برائحة الحجارة المحترقة والقماش المشتعل. نجمة خماسية؛ رمز الديانة الدرزية، اقتُلعت من سقف المقام.
“دخلوا وهم يصرخون الله أكبر، ثم استخدموا شموع المقام ليُشعلوا فيه النار”، يقول ليث؛ عامل بلدية محلّي يرتدي الآن ملابس قتالية: “ثم أهانونا بهتافات طائفية”، يرفض ليث قول المزيد خجلاً.
يقول رجل يقف بجانب ليث: “أنتم خنازير، خونة، أخواتكم عاهرات. هذا ما كانوا يصرخون به”.
بدأ الهجوم عند الفجر في 30 نيسان/ أبريل، وأمطرت قذائف الهاون على القرية لساعات. قرابة الساعة 6:30 صباحاً، وبعد توقّف وجيز سُمح للعائلات بالفرار، دخل مسلحون القرية، نهبوا البيوت، وأحرقوا المحالّ التجارية، وعبثوا بالمقام. لم ينجُ محلّ واحد، بحسب السكّان.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، بل كانت جزءاً من موجة أوسع من العنف الطائفي، الذي استهدف المجتمعات الدرزية في سوريا، اشتعلت بعد تداول مقطع صوتي منسوب إلى شيخ درزي يُقال إنه أساء للنبي محمد.
سارع زعماء في الطائفة إلى نفي الاتّهام، كما أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً يوم الثلاثاء في 29 نيسان/ أبريل، أعلنت فيه فتح تحقيق، لكنّ الضرر كان قد وقع.
بعد واحدة من أشد أحداث العنف الطائفي في تاريخ سوريا الحديث، وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قُتل ما لا يقل عن 134شخصاً بعد أسبوع من الاشتباكات في المناطق ذات الأكثرية الدرزية “السويداء، جرمانا، صحنايا، أشرفية صحنايا”.
شمل القتلى 88مقاتلاً درزياً، 14 مدنياً، 32 جندياً من وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية، وقوات عسكرية تابعة لهم.
شهود عيان يقولون إن عناصر من إدارة الأمن العامّ، أي شرطة الدولة الداخلية، كانوا حاضرين ومتواطئين، وتؤكّد بعض اللقطات التي انتشرت عبر الأنترنت وجودهم، لكنّ دورهم الكامل لا يزال غير واضح.
في الصورة الكبيرة، قُتل مدنيان، أحدهما كان عمّ ليث الذي: “كان جالساً فقط، أعزل. أطلقوا النار عليه، لم نتمكّن من سحب جثّته حتى اليوم التالي”، رصاصات فارغة على الأرض، وعلى جدار قريب، لطخات الدماء وثقوب أحدثها الرصاص تشهد على ما حدث.
يقول ليث بصوت متهدج: “اقتحموا أيضاً منزل والدي وعمره 82 سنة وضربوه، مزّقوا صورة عمّتي، رفعوها من على الحائط وداسوها، وهي كانت توفّيت قبل شهر”.
امتدّ العنف أيضاً إلى ضواحي العاصمة. في 29 نيسان/ أبريل، اندلعت اشتباكات في جرمانا، المدينة ذات الغالبية الدرزية جنوب دمشق. بعد أسبوع، امتلأت محطّة الحافلات في المدينة بمئات العائلات التي تحاول المغادرة، الطريق إلى السويداء مغلق، ولم يتبقَّ سوى بضع حافلات لنقل الناس.
ساندرا، طبيبة تبلغ من العمر 29 عاماً، تحاول الحصول على مقعد في إحدى الحافلات حيث الجو خانق، والركّاب يحشرون أنفسهم ثلاثة أشخاص في مقاعد مخصّصة لشخصين تقول: “كلّ الدروز يريدون العودة إلى السويداء. من بقي، بقي فقط بسبب عمله”.
العنف، الذي وثّقته مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار قلقاً وجودياً في أوساط الطائفة، التي تخشى أن تلقى المصير نفسه الذي لاقاه علويون في مجازر الساحل، التي وقعت قبل أسابيع.
كلّ شخص من الذين التقيناهم يعرف أحداً مات، أو جُرح، أو فُقد، أو شارك في القتال.
القلق منتشر بشكل خاصّ بين الطلاب الدروز في دمشق، وفي حمص، وحتى في اللاذقية، بعد أن سُجّلت هتافات طائفية وتهديدات ضدّهم داخل الجامعات ومساكن الطلّاب، تقول الطبيبة الشابة:”شاركت في مظاهرة في ساحة الأمويين عندما سقط النظام، يبدو ذلك وكأنه زمن بعيد”.
تعمل ساندرا في مستشفى “المجتهد” في دمشق، ولا تعرف إن كانت ستحظى في السويداء بأمان أكثر من دمشق، لكنّها تبرر سفرها”على الأقلّ سأكون مع عائلتي”. “رأيت ذلك بعيني قبل أربعة أيّام”، تواصل بصوت منخفض: “وصل تسعة جرحى من صحنايا إلى قسم الطوارئ، حاولت إحضار طعام لهم، أوقفني الأمن العامّ، وسألوني عن اسمي، قال لي صديق إنهم سخروا من الرجال لأنهم دروز، كما طُلب من الأطباء عدم إجراء تدليك قلبي لرجل مصاب، وتوفّي لاحقاً”.
عند أحد الحواجز تتوقّف الحافلة، تنظر ساندرا بقلق إلى رجال الأمن العامّ الواقفين في الخارج: “لا أثق بهم. لكن ليسوا جميعاً متشابهين، بعضهم طلب من الآخرين أن يتراجعوا عندما سألوا عن اسمي. وليس كلّ السنة متشدّدين، بل العكس، لدي أصدقاء منهم ساعدوني على الحصول على إجازة من المستشفى”.
امرأة أخرى، تقف قريبة تستمع: “أنتِ تعملين في مستشفى المجتهد؟ جدّي أُصيب في صحنايا الخميس الماضي، سمعنا أنه نُقل إلى هناك، لكن عندما جئنا لرؤيته، طردنا الأمن العامّ، ثم قيل لنا إنه نُقل إلى داريا للاستجواب. لا أخبار عنه منذ ذلك الحين، مرّ أربعة أيّام، عمره 75 سنة”.
هذه الموجة من العنف الطائفي ليست مجرّد ردّة فعل، إنها تعكس أحقاداً قديمة، نزاعات على الأراضي، ودوائر انتقام، وتفتّت عميق في سوريا ما بعد الحرب.
سامي وردة، ناشط يبلغ من العمر 27 عاماً من جرمانا، يحاول توثيق العنف مع مجموعة من أصدقائه: “خلال الحرب الأهلية، انضمّ 300 رجل من بلدتنا إلى ميليشيات الشبّيحة، قاتلوا في المليحة في عام 2014″، المهاجمون مؤخّراً جاءوا من هناك: “بعض مقاتلي حزب الله كانوا متمركزين أيضاً في جرمانا، وشاركوا في تلك المجازر آنذاك”.
بعض التحالفات التي تشكّلت خلال الحرب الأهلية والنزاعات المحلّية تشكّل فوضى اليوم.
رعب صامت في الساحل
في حمص وعلى طول المحافظات الساحلية، موطن الأقلّية العلوية في سوريا، الإحساس بالتهديد واضح، وإن كان أقلّ ظهوراً حالياً. في 6 آذار/ مارس، هاجم موالون سابقون للنظام القوّات الحكومية، مما أشعل مجازر أسفرت عن مقتل 1,334 شخصاً، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، منذ ذلك الحين، استمرّ العنف في الظلّ، أحد الاتّجاهات المقلقة: خطف نساء علويات
سجّلت “مجموعة السلم الأهلي “، وهي منظّمة غير حكومية تأسّست بعد سقوط الأسد، 72 حالة خطف نساء، منذ كانون الثاني/ يناير في شرق سوريا وحده.
علي حسن لم يسمع عن شقيقته منذ 13 نيسان/ أبريل شيئاً: “كانت بتول في حافلة متّجهة إلى صافيتا، كانت تراسل زوجها لتطمئن على ابنهما، ثم ساد صمت بعد الساعة الرابعة عصراً”.
آخر صورة لها تُظهرها مبتسمة، بالكحل حول عينيها، مصيرها مجهول يضيف حسن: “ذهبنا إلى الشرطة، واتّصلنا بمعارفنا في الأمن العامّ لا شيء”.
لا يتّهم حسن السلطات بشكل مباشر، لكنّ تقاعسهم يقول الكثير، يقول : “ليسوا مسيطرين، لا يملكون العدد أو القدرة، لو طُبّقت العدالة منذ البداية، لما حدث هذا كلّه”.
تعلو الأصوات المطالبة بتحقيق عدالة انتقالية. ضحايا، ونشطاء، وشخصيّات من المجتمع المدني يقولون إنها السبيل الوحيد لكسر دوائر الانتقام في سوريا، لكنّ السلطات تلتزم الصمت.
بعد مجازر آذار/ مارس، وعدوا بلجنة تحقيق، كان من المُفترض إصدار تقرير خلال شهر، تأخّر بالفعل لشهرين. هذا يغذّي شعوراً بالظلم، في الوقت الذي تخرج فيه سوريا من 14 عاماً من الحرب الأهلية، مُثخنة ولكنّ من دون دم.
درج
————————————–
سوريا وإسرائيل و “خط 7 ديسمبر”/ إبراهيم حميدي
دمشق كانت تطالب تل أبيب سابقا بـ”العودة إلى خط 4 يونيو 1967″ وأن المطلب الأولي حاليا هو عودة إسرائيل إلى “خط 7 ديسمبر 2024”
آخر تحديث 11 مايو 2025
بعد سلسلة تسريبات عن اتصالات سورية–إسرائيلية بوسائل عدة ومن عواصم مختلفة، أكد الرئيس أحمد الشرع بعد لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وجود “مفاوضات غير مباشرة” بين دمشق وتل أبيب لـ”تهدئة الأوضاع وعدم خروج الأمور عن السيطرة”.
بالفعل، بات بحكم المؤكد أن الأسابيع الماضية شهدت سلسلة وساطات شارك فيها رجال أعمال وباحثون ومسؤولون أميركيون. وتتراوح التوقعات بين بحث إجراءات محددة لمنع الصدام العسكري وانضمام سوريا إلى “الاتفاقات الإبراهيمية”.
لكن على ماذا تفاوضت سوريا وإسرائيل سابقا؟
لا بد من خلفية تاريخية، تفيد بأن مفاوضات ولقاءات كثيرة جرت في العقود الماضية قبل نكبة فلسطين في 1948 وبعدها في مفاوضات الهدنة، إضافة إلى لقاءات لاحقة في عهد أديب الشيشكلي. كما وقّعت سوريا وإسرائيل اتفاق فك الاشتباك في 1974 بعد أشهر من “حرب أكتوبر” في 1973.
المرحلة الأهم في المفاوضات السورية-الإسرائيلية كانت برعاية أميركية بعد انعقاد مؤتمر مدريد في 1991، التي استمرت إلى فبراير/شباط 2011، أي بعد اندلاع الاحتجاجات السورية. وفي عقد التسعينات كانت المفاوضات تتركز على مبدأ “الأرض مقابل السلام”، أي انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة في يونيو/حزيران 1967 مقابل موافقة سوريا على إقامة علاقات سلمية عادية وتبادل دبلوماسي وتجاري.
لكن في العقد الأول من حكم بشار الأسد وبعد انحيازه الكبير نحو إيران و”حزب الله”، باتت المقايضة، “الأرض مقابل التموضع الإقليمي”، أي استعادة الجولان مقابل تخلي دمشق عن تحالفها مع طهران و”حزب الله”. وقال الوسيط الأميركي فريد هوف إن بشار الأسد وافق على هذه الصفقة مبدئيا، لكن سرعان ما قرر مواجهة الاحتجاجات بالنار، ما زاد من انغماسه في “المحور الإيراني” واعتماده عليه، الأمر الذي واجهته إسرائيل بملاحقة أصول إيران و”حزب الله” في سوريا، بقبول من الجيش الروسي الذي تدخل في 2015 ودعم من الجيش الأميركي الذي تدخل لمحاربة “داعش” في 2014.
نقطة التحول الكبرى في سوريا، كانت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. سقط نظام الأسدين وخرجت إيران و”حزب الله” وتسلم الحكم أحمد الشرع. أما إسرائيل، فإنها ردت بعشرات الغارات التي دمرت جميع الأصول الجوية والبرية والبحرية والبحثية للدولة السورية. كما احتلت المنطقة العازلة بموجب اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 واحتلت تسع تلال بينها واحدة استراتيجية في جبل الشيخ. وبات بعض المسؤولين فيها يدعمون خيار تقسيم سوريا.
جيوسياسياً، حصل تطور مهم إذ باتت تركيا لاعبا عسكريا مهماً في سوريا مقابل خروج إيران وتراجع نفوذ روسيا. وبالفعل، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع كانت أنقرة تخطط أن تكون قواعد عسكرية تركية وسط سوريا. وبات الطرفان على وشك المواجهة العسكرية ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقناع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرسال مبعوثيهما إلى أذربيجان لبحث فك الاشتباك.
وحصل تطور آخر في سوريا، تمثل في إعلان نتنياهو استعداده للدفاع عن الدروز جنوب سوريا وفي جرمانا قرب دمشق، بل إن الجيش الإسرائيلي شن غارة قرب القصر الرئاسي السوري مقر إقامة الشرع، للضغط عليه للابتعاد عن تركيا وتقديم بعض الضمانات لدروز سوريا.
أمام هذا المشهد على ماذا يتفاوض الطرفان؟
لا شك أن التحول الاستراتيجي السوري قد حصل لدى إخراج إيران من سوريا لأول مرة من 45 سنة وهزيمة “حزب الله” في لبنان. لكن من الحكمة، أن يتمسك الجانب السوري بأن تكون المفاوضات عبارة عن “اتصالات غير مباشرة” لمناقشة قضايا تخص منع الصدام العسكري وبناء الثقة، مثل: التأكد من خروج إيران، ومنع تهريب السلاح إلى “حزب الله”، ومنع وجود خلايا جهادية أو قتالية جنوب سوريا خصوصا بعد تجربة إسرائيل في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإجراءات توسع الإدارة الدرزية في السويداء والتأكيد على عدم وجود أي نيات عدائية تجاه دول الجوار، واتخاذ إجراءات لتعزيز التموضع الإقليمي بالقطع مع وكلاء إيران، بالتزامن مع اتصالات تركية-إسرائيلية لمنع الصدام العسكري وتنسيق الانتشار التركي شمالي سوريا والضمانات الأمنية لإسرائيل في الجنوب. من هناك يمكن الإفادة من الإرث التركي في الوساطة بين دمشق وتل أبيب في 2008، عندما رتبت لقاء بين بشار الأسد وإيهود أولمرت، تم التراجع عنه في آخر لحظة.
وعلى سوريا أن ترهن الانتقال من “الاتصالات غير المباشرة” إلى “المفاوضات المباشرة” بانسحاب إسرائيل من خط 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أي خروج إسرائيل من المواقع التي احتلتها بعد سقوط الأسد. ولا شك أن “المفاوضات المباشرة” التي تحتاج تحضيرا معمقا، سترمي إلى البحث في مستقبل الجولان السورية المحتلة.
صحيح أن ترمب اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، لكن لا يمكن توقع قبول سوريا والحكم الجديد بالتخلي عن السيادة السورية على الأرض المحتلة، ويجب أن يبقى هذا مطلبا تفاوضيا خلال مسيرة التباحث حول توقيع اتفاق سلام، ذلك أن سوريا تختلف عن غيرها من الدول التي انضمت إلى “الاتفاقات الإبراهيمية”، أن لها أرضا محتلة.
ومن غير المتوقع أن يكون توقيع اتفاق سلام أولوية للحكم السوري الجديد. فسوريا منهكة ومدمرة ولها أولويات أخرى. ومن غير المتوقع أن يكون هذا أولوية لحكومة إسرائيل المتطرفة. لكن الطرفين معنيان بإجراءات تستجيب للواقع الجديد والتطورات الهائلة في سوريا والإقليم. يكفي القول، إن سوريا كانت تطالب إسرائيل سابقا بـ”العودة إلى خط 4 يونيو 1967″ وأن المطلب الأولي حاليا هو عودة إسرائيل إلى “خط 7 ديسمبر 2024”.
المجلة
————————
=========================
الموقف الأميركي اتجاه سوريا، مسالة رفع العقوبات، الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة السورية تحديث 13 أيار 2025
لمتابعة هذا الملف التبع الرابط التالي
العقوبات الأميركية على سوريا الجديدة وسبل إلغائها
—————————–
وماذا لو ألغى ترامب العقوبات على سوريا؟/ عمر قدور
الثلاثاء 2025/05/13
مساء يوم الأحد، كتب ترامب على حسابه عبر منصة “تروث سوشيال”، أنه سيعلن لاحقاً الخبر الأشدّ تأثيراً على الإطلاق. وحدهم بعض السوريين هم الذين راحوا يعبّرون على السوشيال ميديا عن تشوّقهم للقرار التاريخي المنتظَر، على اعتبار أنه قد يكون إعلاناً من ترامب عن لقائه الشرع أثناء زيارته المملكة العربية السعودية، أو إعلاناً منه يمهّد لذلك اللقاء المرتقب برفع العقوبات الأميركية على سوريا.
كما هو معلوم، يُنظر على نطاق واسع إلى لقاء ترامب بالشرع بوصفه نيلاً للشرعية من القوة الكبرى العظمى، بما تتضمنه من مزايا العلاقة الجيدة مع واشنطن، ولا تقل عنها تأثيراً المزايا المالية المنتظرة من دول الخليج. فمن المعلوم أيضاً أن تنفيذ الوعود الخليجية السخيّة تعيقه العقوبات الأميركية، مثلما تعيق المساعدات الأوروبية المأمولة، وهي أقل من الخليجية وليست بلا شروط حتى الآن. أما واشنطن في عهد ترامب فلا تُنتظر منها المساهمة مالياً، بل إن بعض برامج المساعدات المدعومة أميركياً قد توقّف بالفعل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
إذاً، يكاد رفع العقوبات الأميركية أن يكون الحل السحري للضائقة المعيشية الموروثة من حكم الأسد، وقد تفاقمت لدى الشرائح الأفقر بعد سقوطه بسبب ارتفاع الأسعار مع بقاء دخل الموظفين محدوداً، أو حتى التأخر في دفع الرواتب. التصريحات الصادرة عن المسؤولين في دمشق تعزز هذا التصور. فقد قيل تارةً إن العقوبات تعرقل المضي في مشروع العدالة الانتقالية، وقيل تارةً أخرى إنها تؤثّر سلباً على ضبط الأمن في البلد، أي أن ملفات أساسية مثل العدالة والسلم الأهلي رُبطت بإزالة العقوبات، مع ما تعنيه هذه التصريحات في حقل المساومة السياسية.
ما هو مؤكد أن العقوبات الدولية، في معظم حالات فرضها، لم تؤدِّ الغرض المعلن، وكان تأثيرها الأكبر على الفئات الأضعف في البلدان التي استُهدفت أنظمتها بالعقوبات. واليوم، لأول مرة يلتقي معظم السوريين، من أنصار السلطة أو سواهم، على مطلب إنهاء العقوبات بسبب تأثيراتها على الجميع. لكن الظن بأن رفعها سيكون حلاً لمشاكل عديدة ومترابطة هو ظن ساذج. وترويجه إذا كان يخدم بروباغندا اعتبارها هي المشكلة، فسيصطدم بعد مدة بواقع أنها ليست المشكلة الوحيدة أو الأكبر، وليست إلا جزءاً من الحل إذا كان الحل الجذري مطلوباً.
لا شك في أن تدفق المساعدات الخليجية سيساعد على دفع الرواتب وما هو متأخر منها، وربما تنفيذ الوعود المتعلقة بزيادتها، ما ينعكس تنشيطاً للاقتصاد السوري بالمعنى الكلي. وكذلك سيكون حال المساعدات المتوقعة فيما يُسمى “التعافي المبكّر”، في حقول الطاقة والصحة والتعليم، فالإنفاق فيها سينعكس أيضاً على تنشيط الاقتصاد بمجمله، لأن لكل حقل منها متطلبات تكميلية تجعله مرتبطاً بالشبكة العامة.
النشاط المتوقع لن يمر بلا منغّصات، إذ من المتوقع في المقابل أن يرتفع معدل النمو، وأن يزداد التضخم الذي تدفع الفئات الأفقر ضريبته عادةً، لتعود المطالبة من جديد برفع الأجور والدوران في الحلقة ذاتها. ما يكسر الحلقة هو المضي في تحفيز الإنتاج الاقتصادي، وخلق فرص عمل حقيقية. لكن قبل الحديث عن الاستثمارات المأمولة من الضروري الانتباه إلى أن البلد سيبدأ رحلة التعافي من نقطة عجز تبلغ حوالى 500 مليار دولار، معظمها بسبب التدمير الكلي أو الجزئي، والقليل منها لتعويض الاهتراءات الناجمة عن التقادم في معظم الخدمات العامة.
تحتاج سوريا ضخ مليارات الدولارات سنوياً، لا أقل ربما من عشرة مليارات، وهو رقم ليس بالقليل، من أجل إعادة الإعمار، وأيضاً على سبيل الاستثمار الضروري كي لا يبقى الاقتصاد مرهوناً بالمساعدات إلى أجل بعيد. التعويل ولو جزئياً على الثروات الطبيعية فيه الكثير من المبالغة، لأن إنتاج النفط في أحسن الأحوال قد يحقق الاكتفاء الذاتي، أي أن الاهتمام ينبغي أن ينصرف إلى الاستثمار في مختلف القطاعات لتحقيق الاكتفاء فيها، ثم خلق فائض للمنافسة. مع التنويه بحاجة سوق العمل إلى مهارات قد لا تكون متوفرة بعد سنوات الحرب، فضلاً عن استقبال ملايين من اللاجئين في الجوار الذين لم يُتح لهم التأهيل الجيد، وهم سيضيفون عبئاً اقتصادياً على ما هو موجود حالياً.
ما سبق يبقى ضمن تصور إيجابي لسوريا موحَّدة آمنة. ومن دون بيئة فيها حد أدنى من الاستقرار والأمن، سيكون لامنطقياً توقّع وصول مساعدات ذات أثر يتعدى الإغاثة الإنسانية. بعبارة أخرى، يعود الربط الذي أتى ضمن تصريحات رسمية سورية، لكن معكوساً هذه المرة. فإذا صحّ ربط الأمن برفع العقوبات فهذا يستتبع تحقيقه من أجل جذب المساعدات والاستثمارات، وسيكون المطلوب تحقيقه بشفافية كافية تخرجه من سوق المساومات السياسية، أي يجب ألا يكون الأمن ورقة تستخدمها السلطة خارجياً، وإنما يجب أن يتحقق على نحو أكيد وموثوق لجهة استدامته؛ على الأقل يجب أن تكون الإجراءات جديرة بالثقة.
في الواقع، هناك ضخّ إعلامي، وتصريحات لمسؤولين، تضخّم من وجود الفلول. التضخيم الذي يخدم السلطة مؤقتاً، إذ يشدّ عصب مواليها والمترددين إزاءها، هو نفسه الذي لن يخدم طموحاتها الاقتصادية إذا أُخِذ ما يحكى عن الفلول على محمل الجد. أما إذا نُظر إليه كتضخيم متعمد فهذا سيشكك في مصداقية السلطة، والحال نفسه فيما يخص الكلام عن فصائل غير منضبطة، فتصديق الرواية يعني أن السلطة غير قادرة على ضبط الفصائل المعنية، وعدم تصديقها يؤدي إلى مسؤولية السلطة عن الظاهرة بما يزرع الشكوك حولها والتخوّف مما تضمره للمستقبل.
نضيف إلى ذلك، أن البلد محكوم بمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، أي أنه في حالة عدم يقين سياسي حتى انقضاء الفترة المحددة، ولا يغيّر من ذلك إعطاء وعود يُفهم منها تصرُّف الحكم كأنه باقٍ لأجل أبعد. عدم وضوح الأفق السياسي للبلد هو بمثابة نقطة إضافية من عدم الأمان، وأغلب الظن أن الأموال الوافدة إلى سوريا ستكون بمعظمها مساعدات دولية، لأن الرأسمال الخاص لن يغامر في حالة عدم يقين. وحتى التوجّه الذي أعلنه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى النموذج السنغافوري لا يملك الجاذبية، فهو ابن زمنه قبل ستة عقود، وخلطة الاستبداد مع الانفتاح الاقتصادي السنغافوريين غير قابلة للتكرار؛ ليس بعد ثورة من أجل الحرية.
باستخدام مجاز متداول؛ سوريا عالقة في عنق الزجاجة، والخلاص منه قد يعني العودة إلى الزجاجة بدل الخروج منها. العقوبات الأميركية ليست وحدها المشكلة أو الحل، ويمكن الاستئناس بالتشويق الذي صنعه ترامب مساء الأحد. إذ بعد إعلان نيته إصدار الخبر الأشد تأثيراً أعلن عن خفض أسعار الأدوية. وبينما ترقّب البعض إعلانه عن مفاجأة مرتبطة بالصين أو بأوكرانيا وروسيا، أتى الخبر والاهتمام متوجهين كلياً إلى الداخل. لعل ترامب، على علاته، يشير إلى الوجهة الصائبة دائماً.
المدن
——————————–
ما هو مشروع “مارشال السوري” الذي طلبه الشرع من ترامب؟/ محمد ياسين نجار
13/5/2025
تكتسب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مِنطقة الخليج، المقرّرة بين 13 و16 مايو/ أيار 2025، أهمّية استثنائية في ظلّ التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وبينما تتناول اللقاءات ملفات الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي والسلام، يبرز “مشروع مارشال السوري” كبند محتمل على جدول المباحثات، بوصفه رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة إعمار سوريا، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي عبر التنمية لا النزاع.
ما هو مشروع مارشال الأميركي؟
هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسميًا في 5 يونيو/حزيران 1947. بلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من أبريل/نيسان 1948 حتى يونيو/ حزيران 1952.
خلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%.
الغرب ومشروع مارشال السوري: شراكة إنمائية أم مقايضة سياسية؟
في سياق سياسي لافت، ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع مارشال خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة مارشال.
كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، وطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج.
نجاح هذا المشروع مشروط بدعم غربي جادّ، ليس من أجل سوريا فحسب، بل من أجل إعادة هندسة توازنات الشرق الأوسط على أسس تنموية تشاركية، بديلًا عن التنافس العسكري التقليدي. كما أن الاتحاد الأوروبي يرى فيه وسيلة لاحتواء تداعيات ما بعد سقوط نظام الأسد، سواء من حيث موجات اللجوء، أو التهديدات الأمنية.
إحياء ميراث مارشال.. ولكن بصيغة سورية
يستعير المشروع اسمه من الخطة الأميركية، لكنه لا يكتفي بالمساعدات أو إعادة الإعمار التقليدي، بل يطرح تصورًا شاملًا لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية عادلة، من خلال:
تأسيس بنى مؤسساتية مدنية.
دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية.
تنمية الاقتصاد الإنتاجي بعيدًا عن الرَّيعية.
إطلاق بنية تحتية تكنولوجية وسياحية فاعلة.
ويُقدّر الخبراء الاقتصاديون الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 250 مليار دولار، تمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2035، بتمويل من دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استثمارات خاصة.
رؤية اقتصادية عابرة للحدود: الخليج وأوروبا شريكان
لا يقتصر المشروع على الداخل السوري، بل يضع سوريا في قلب منظومة اقتصادية جديدة، تربط الخليج بتركيا، وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الغاز والطاقة.
يتوقع أن يلعب الخليج دورًا مركزيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للدخول في شراكات طويلة الأمد.
ويرى خبراء أنّ هذا التكامل يمكن أن:
يقلص موجات الهجرة غير الشرعية.
يضعف من بيئات التطرف.
يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الخليجي والأوروبي.
يعيد تعريف سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والتجارة.
وادي السيليكون وسياحة ما بعد الحرب
من أبرز ابتكارات المشروع، اقتراح إنشاء “وادي السيليكون السوري” في مدينة حلب، كمنطقة تكنولوجية حرة، تحتضن الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، وتُشجّع على عودة الكفاءات السورية من المهجر.
كما يسعى المشروع إلى إحياء المواقع السياحية التاريخية في تدمر، حلب القديمة، دمشق، إدلب، وحماة، وربطها بسياحة دينية وثقافية تُدرّ دخلًا طويل الأمد وتعزز من الهوية الوطنية.
الحوكمة والشفافية: ضمانات النجاح
يرتكز نجاح المشروع على:
إنشاء هيئة رقابة مستقلة تخضع لبرلمان انتقالي سوري، وتنشر تقارير مالية ربع سنوية، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية.
يُعد إشراك المجتمع المدني السوري عنصرًا حاسمًا في منع تسييس المشروع وتحويله إلى أداة نفوذ بيد أي طرف.
الاستفادة من الكفاءات السورية الاقتصادية والتقنية والإدارية، خاصة المغتربين الذين اطلعوا خلال الأعوام الماضية على معايير الجودة والتنفيذ للاستفادة منها وتجاوز السلبيات التي كانت تعترضهم.
سوريا جديدة: من ساحة صراع إلى محور استقرار
لا يهدف المشروع فقط إلى معالجة تداعيات ما بعد الأسد، بل إلى إعادة تشكيل الدولة السورية من خلال تعزيز اللامركزية الإدارية، ودعم الإنتاج المحلي، وربط سوريا بشبكات نقل وطاقة إقليميّة.
يرى مراقبون أن المشروع قد يوجّه اهتمام القوى الدولية نحو أدوات التنمية بدل القوة، إذا ما توافرت تسوية سياسية وتوافق إقليمي- دولي يمنح المشروع شرعيته.
هل هو مشروع واقعي أم رؤية مؤجلة؟
رغم الإشادة بجرأة الطرح، يرى بعض المحللين أن تعقيدات الواقع السوري وتضارب المصالح الدولية وغياب تسوية شاملة، تجعل المشروع حتى اللحظة إطارًا نظريًا في انتظار لحظة سياسية مناسبة.
لكن في المقابل، قد تمنح البراغماتية التي يتمتع بها الرئيس الشرع، إلى جانب الحاجة الخليجية والغربية للاستقرار والخروج من حالة الركود الاقتصادي، زخمًا حقيقيًا للمشروع إذا طُرح ضمن تفاهمات دولية أوسع.
خاتمة: سوريا ما بعد الحرب.. هل يمكن أن تكون قصة نهوض؟
في عالم عربي مثقل بالصراعات، وأمام قوى دولية تتردد بين التدخل والانسحاب، يقدّم “مشروع مارشال السوري” بصيص أمل ونموذجًا بديلًا، لا يقوم على تقاسم النفوذ، بل على شراكة تنموية حقيقية.
نجاح هذا المشروع يتوقّف على عاملين أساسيين: إرادة سياسية سورية صادقة منفتحة على الجميع، وشبكة إقليمية- دولية مسؤولة ترى في سوريا فرصة للتّعافي، لا ساحة للصراع المفتوح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
وزير سابق في الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية
الجزيرة
——————————
الشرع – ترمب.. هل ستعيد 45 دقيقة سوريا إلى الخريطة الدولية؟/ عبد الناصر القادري
2025.05.13
بين أيار 2017 – وأيار 2025 المكان نفسه، والأشخاص تقريباً أنفسهم زعماء الخليج وعدد من الزعماء العرب والرئيس العائد بعد غيبة دونالد ترمب، وفي ظل ذلك تغيرت الظروف والأوضاع الجيوسياسية في منطقة تعيش لهيب حروب وتوترات واتفاقيات وصفقات، لم يعد للمخلوع بشار الأسد أي جدول أعمال أو ذكر أو معنى سوى أنه “مخلوع”، رغم أنه لولا عملية “ردع العدوان” كاد أن يناطح السحاب ليحضر واحدة من أهم القمم العربية الأميركية بحضور الرئيس العائد من ولايته الأولى دونالد ترمب.
الجديد أيضاً، هو مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع وإمكانية لقائه مع الرئيس ترامب بشكل منفرد أو على هامش لقاءات أخرى، لبحث ملف رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أو تخفيفها كما تحدث ترمب قبل سفره إلى الرياض.
45 دقيقة.. ترمب والشرع
ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، أن الرئيس الشرع سيزور السعودية يوم الأربعاء، بالتزامن مع زيارة الرئيس ترمب ومشاركته في قمة مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن الرياض تعمل على ترتيب لقاء لمدة 45 دقيقة بين ترمب والشرع على هامش القمة، بحسب الصحيفة.
ووفق المصادر، فإن ترمب أبدى موافقة مبدئية على “منح الشرع وقتاً للاستماع”، بينما لم تؤكد واشنطن رسمياً عقد الاجتماع بعد.
وفي سياق متصل، كشفت شبكة “فوكس نيوز” أن جولة الرئيس ترمب في الشرق الأوسط قد تحمل معها تحولاً استراتيجياً في العلاقة بين واشنطن ودمشق، حيث تبرز سوريا كفرصة محتملة لإعادة تشكيل النفوذ الأميركي في المنطقة.
ووفقاً للشبكة، يُطرح اسم الشرع كشريك غير متوقع لترمب في مساعٍ دبلوماسية قد تمنحه انتصاراً سياسياً مهماً.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن الشرع يرى في ترمب الزعيم القادر على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، في حين أبدى ترمب انفتاحه على فكرة رفع العقوبات عن سوريا وتجديد العلاقات الثنائية.
من جهتها، أكدت مصادر في الخارجية السورية أن دمشق تسعى لعلاقة استراتيجية مع واشنطن تقوم على المصالح المشتركة، وتشمل تعاوناً استخبارياً واقتصادياً واسع النطاق، إلى جانب تسهيلات محتملة لدخول الشركات الأميركية إلى السوق السوري.
كما تحدثت تقارير عن جهود تُبذل لعقد لقاء بين ترمب والشرع خلال زيارته إلى الخليج هذا الأسبوع، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد سوريا إلى الساحة الدولية بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة والحرب.
لحظة مفصلية
واعتبرت باحثة أميركية أن هذه الفرصة قد تمثل لحظة مفصلية في علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن سوريا باتت في موقف مغاير لطهران لأول مرة منذ سنوات، ما قد يفتح المجال أمام تحالفات جديدة وتغييرات إقليمية جذرية.
ويوم الإثنين، كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي بنظيره السوري، خلال زيارته إلى السعودية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي الشرع بترمب ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون.
وتابعت أن اللقاء سيكون فرصة ليضغط الرئيس السوري من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.
وأبرزت أن هذا الضغط قد يقابله تقديم “عدة تنازلات، بما في ذلك إتاحة الفرصة للشركات الأميركية لاستغلال الموارد الطبيعية في صفقة معادن على غرار ما حدث في أوكرانيا”.
وتكافح سوريا لتخفيف العقوبات الأميركية، والتي تبقي البلاد في عزلة عن النظام المالي العالمي وتجعل التعافي الاقتصادي صعباً للغاية بعد حرب طاحنة دامت 14 عاماً قادها بشار الأسد ضد السوريين الثائرين عليه، ثم تحول الملف السوري إلى التدويل وصراعات إقليمية ما زالت آثارها إلى اليوم.
وفي إشارة إلى تحول محتمل في سياسة واشنطن، قال ترمب، الإثنين، إنه قد يخفف العقوبات الأميركية، مضيفاً “سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات.. قد نرفعها عن سوريا، لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة”.
وأفادت “التايمز”، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الشرع قد يعرض أيضاً “إجراء محادثات بشأن الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية”.
وأكملت: “قد يكون (الشرع) مستعداً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني في جنوب غربي سوريا، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة بجوار مرتفعات الجولان، وهي منطقة احتلتها عام 1967”.
سبق أن اعترفت إدارة ترامب في عام 2019 بهذه المنطقة، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967، كأراضي إسرائيلية وهو ما رفضه غالبية المجتمع الدولي.
ومع ذلك، يبدو أن هناك انقساماً بين كبار مستشاري ترامب حول جدوى اللقاء مع الشرع.
وتُعتبر مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، من بين أولئك الذين يُفهم أنهم ما زالوا حذرين بشأن اللقاء، وقد يحاولون منعه، حسب المصدر ذاته.
في المقابل، يُعتقد أن آخرين، بمن فيهم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أكثر تأييداً لعقد هذا اللقاء، لأنهم يدركون مدى استعداد ترمب للاستغناء عن البروتوكول والتقاليد لإبرام الصفقات، وفق الصحيفة.
برج ترمب في سوريا
نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دمشق.
وقالت المصادر إن الصفقة تشمل أيضا منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل، والتعاون ضد إيران.
وأضافت أن هذه العناصر جزء من “إستراتيجية” يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأميركي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء.
ووفقا لرويترز، يحاول جوناثان باس -وهو ناشط أميركي مؤيد لترامب التقى مع الشرع في 30 أبريل/نيسان الماضي لمدة 4 ساعات بدمشق- إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية ترتيب لقاء تاريخي -وإن كان مستبعدا للغاية- بين الرئيسين الأميركي والسوري هذا الأسبوع على هامش جولة ترامب في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن باس قوله “لقد أخبرني (الشرع) أنه يريد بناء برج ترامب في دمشق، يريد السلام مع جيرانه، ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل”.
وقالت إن باس يأمل أن يساعد اجتماع ترامب مع الشرع في تخفيف موقف الإدارة الأميركية تجاه دمشق وتهدئة التوتر المتصاعد بين سوريا وإسرائيل.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم الرئيس ترمب في دمشق.
وقالت المصادر إن الصفقة تشمل أيضاً منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل، والتعاون ضد إيران.
وأضافت أن هذه العناصر جزء من “إستراتيجية” يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأميركي خلال جولته في الخليج.
ووفقاً لرويترز، يحاول جوناثان باس -وهو ناشط أميركي مؤيد لترامب التقى مع الشرع في 30 نيسان الماضي لمدة 4 ساعات بدمشق- إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية ترتيب لقاء تاريخي -وإن كان مستبعدا للغاية- بين الرئيسين الأميركي والسوري على هامش جولة ترامب في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن باس قوله “لقد أخبرني (الشرع) أنه يريد بناء برج ترمب في دمشق، يريد السلام مع جيرانه، ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل”.
وقالت إن باس يأمل أن يساعد اجتماع ترامب مع الشرع في تخفيف موقف الإدارة الأميركية تجاه دمشق وتهدئة التوتر المتصاعد بين سوريا وإسرائيل.
بين قمتين
بعد قمم 2017 التي حضرها ترمب، عاشت المنطقة العربية حالة من التوتر العربي والإقليمي بشكل واسع، وشهدت عمليات تهجير قسرية في سوريا، صحيح لم تشهد حروباً تقليدية كما يفتخر ترمب دوماً، إلا أنها لم تكن فترات حكمه سهلة أبداً على شعوب “الشرق الأوسط”.
غاب ترمب عن المشهد السياسي المباشر، إلا أنه بقي حاضراً بتأثير سياساته على المنطقة خلال فترة الرئاسية المشاغبة، والتي حملت روحاً سياسية مختلفة من ناحية التعاطي والسياسات والراديكالية في القرارات.
خلال زيارة ترمب للسعودية في أيار 2017، عُقدت ثلاث قمم (سعودية-أميركية، خليجية-أميركية، وعربية إسلامية-أميركية) أسفرت عن نتائج استراتيجية أبرزها توقيع صفقات واتفاقيات بقيمة 460 مليار دولار، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية بين واشنطن والرياض، وتأسيس مركز لمكافحة تمويل الإرهاب.
كما أكدت القمم على عزل إيران، والتعاون لإنهاء أزمات المنطقة، خاصة في سوريا واليمن، مع دعوة عربية إسلامية لتولي زمام المبادرة في مواجهة التطرف، وبدء فصل جديد من الشراكة مع الولايات المتحدة.
مرت سوريا يومها على هامش الهامش في القمم العربية الأميركية، رغم أن ترمب نفسه كان قد أصدر قراراً قبل أقل من شهر (7 نيسان 2017) بتنفيذ هجمات على مطار الشعيرات بحمص التابع للنظام المخلوع الذي شن هجوماً بالسلاح الكيماوي على المدنيين في خان شيخون بريف إدلب ما أدى إلى مقتل 100 شخص وإصابة 450 آخرين.
تحليلات كثيرة تشير إلى أن وضع سوريا تغير، ولم تعد على هامش الاهتمام الأميركي، لدرجة أن الرئيس نفسه قد تحدث عنها، والجيمع يسأله عنه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سأله عن العقوبات وآخرين كثر (لم يحددهم)، لكن يرجح أنها دول الخليج (السعودية وقطر والإمارات)، ما يعني أن ترمب سيكون أكثر اهتماماً بسوريا في المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظل المعطيات التي أوردتها تسريبات الصحف الغربية.
الجديد ربما أن سوريا اليوم ليست على هامش القمة التي سيخيم عليها اتفاقيات اقتصادية ومواضيع مهمة لها صلة بإيران وإسرائيل وعدوانها على غزة ولبنان وحتى اليمن والعراق، ولكن سوريا هي المحطة المهمة.
في قمة الرياض 2025، قد يُحدث دونالد ترمب تحولاً جوهرياً في الملف السوري، بخلاف ما جرى في قمة 2017 التي كانت سوريا فيها “خارج الصورة” سياسياً.
هذه المرة، يقترب الملف السوري من قلب النقاش السياسي الإقليمي، وهناك احتمالات حقيقية لأن يشكّل اللقاء المرتقب بين ترمب وأحمد الشرع نقطة انعطاف في العلاقة الأميركية-السورية، وفي موقع سوريا من النظام الإقليمي الجديد.
ما الذي قد يغيره ترمب في هذه القمة بالنسبة لسوريا والشرع؟
لقاء قد يعيد سوريا إلى الخريطة الدبلوماسية، وربما يكون أول اعتراف سياسي مباشر من واشنطن بشرعية القيادة الجديدة في دمشق، كما من الممكن أن يرسل إشارة دولية أن سوريا لم تعد “منبوذة” أو مجرد ورقة تفاوضية، بل شريك محتمل في ترتيبات الشرق الأوسط القادمة.
ترمب ألمح صراحة إلى إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهو تحول كبير عن السياسات السابقة، خاصة “قانون قيصر”.
الشرع سيضغط باتجاه هذا الهدف مقابل تنازلات تشمل فتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأميركية وفتح مجال التفاوض أمنياً مع الاحتلال الإسرائيلي.
الحديث عن “برج ترمب” في دمشق ليس مجرد دعاية، بل إشارة إلى إمكانية دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الخليجية–الأميركية، وربط التعافي الاقتصادي السوري باستثمارات سياسية وتجارية.
سوريا في عهد الشرع أعلنت ابتعاداً عن إيران، واقتربت أكثر من تركيا والعرب حلفاء الولايات المتحدة تقليدياً، وهو انخراط أوسع بالنسبة لسوريا في النظام العربي الجديد والتحالفات الأمنية–الاقتصادية التي تقودها السعودية وقطر وبدعم أميركي.
قد يكون احتمال الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية أو القبول بتفاهمات مع إسرائيل مجرد تسريبات إعلامية تحمل تهويلاً (مثل مناطق منزوعة السلاح أو تعاون أمني بجنوب سوريا)، إلا أنه أمر وارد الحدوث في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
كما تعرض دمشق تعاوناً استخباراتياً مع واشنطن، ما قد يفتح باباً لتعاون في مكافحة الإرهاب وتثبيت النفوذ الأميركي في مناطق كانت خاضعة للنفوذ الإيراني أو الروسي.
تلفزيون سوريا
———————————-
واشنطن تمدد “حالة الطوارئ الوطنية”.. أي رسالة للحكومة السورية؟/ محمد كساح
11 مايو 2025
بين من يرى أن تمديد واشنطن لحالة الطوارئ الوطنية، المفروضة على سوريا، مجرد إجراء روتيني، ومن يقول إنها رسالة واضحة لحكومة دمشق بأن جوهر الأزمة لم يحل، تسود حالة من الضبابية حول الموقف الأميركي إزاء الملف السوري.
وأعلن البيت الأبيض عن تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي. وجاء في نصّ التجديد أن “استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338 أمرٌ ضروري” لأن “افتقار سوريا لبنى الحكم التنظيمية وضعف قدرتها على ضبط الأسلحة الكيميائية، ومكافحة المنظمات الإرهابية، لا يزال يشكل تهديدًا استثنائيًا وغير اعتيادي لأمن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها”.
وفي تصريحات متزامنة مع تجديد حالة الطوارئ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، للصحافيين في معرض إجابتها حول سؤال متعلق بتخفيف العقوبات الأميركية على سوريا في المدى المنظور: “لا أستطيع قول ذلك على الإطلاق. الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر استجابة مناسبة للمطالب التي عرضتها عليكم مرارًا هنا”.
وأضافت أن الوضع في سوريا “تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعًا، وهو أمر لا ندعمه كما ذكرت، أو كان مؤشرًا على تحرك في اتجاه نؤيده”.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، فرضت حالة الطوارئ على سوريا بموجب “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان” لعام 2003، وقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”.
إجراء روتيني
ويوضح السياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة، أيمن عبد النور، أن “التجديد مجرد إجراء روتيني”، مضيفًا، في حديث لـ”الترا سوريا”، أن مدة حالة الطوارئ الوطنية سنة كاملة، يتم تجديدها بشكل شبه أوتوماتيكي في نفس اليوم سنويًا وهو الثامن من أيار/مايو، إذا لم يكن هناك متغيرات جدية لوقف التجديد.
ويتابع: “لكي لا تجدد حالة الطوارئ يجب أن يتم توقيع القانونيين الأميركيين على وثيقة تؤكد رفع المسببات التي تم الاستناد إليها لفرض هذا القرار الذي يمدد منذ سنوات، وطالما أنه لا جديد يخص هذه المسببات، حتى مع تبدل النظام السابق ووصول السلطة الجديدة، فإن القانون سيجدد”.
ويلاحظ عبد النور أن الحكومة السورية لم تحقق سوى جزءًا بسيطًا من البنود الأميركية الثمانية، وبالتالي فإن السائد حاليًا هو بقاء كل شيء على ما هو عليه، لكن لا يجب تضخيم تجديد حالة الطوارئ كونها إجراء شبه روتيني ولن ينعكس سلبًا على أي تفاهمات أو اتفاقات لاحقة.
ويضيف أنه في حال بادرت الحكومة السورية إلى تنفيذ المطالب الأميركية قبل نهاية حزيران/يونيو، فحينها سوف يتم تمديد رخصة الاستثناءات المتعلقة بالعقوبات على سوريا لمدة عام أو عامين، وذلك في الرابع من تموز/يوليو القادم مع إضافة بنود جديدة لا تقل عن ثلاثة بنود، بشكل مؤكد، لكن بشرط تنفيذ الشروط كاملة.
رسالة واضحة لدمشق
وحسب مراقبين، يحمل قرار تجديد حالة الطوارئ الوطنية الأميركية بشأن سوريا رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أنّ جوهر الأزمة السورية لم يُحلّ، بغض النظر عن سقوط نظام الأسد وصعود سلطة انتقالية جديدة.
ويرى الكاتب والباحث الأكاديمي، مالك الحافظ، أن الفقرة الأساسية في القرار تقول بوضوح إنّ المشكلة ليست فقط في الأفراد بل في بنى الحكم الضعيفة، وفشل ضبط الأسلحة الكيميائية، والقدرة على مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن “هذا يعني أنّ واشنطن ترى أنّ السلطة الانتقالية حتى اللحظة لم تُقدّم مؤشرات حقيقية أو ملموسة تختلف نوعيًا عن المشكلات السابقة، بل قد تعتبرها استمرارًا لحالة من الهشاشة والانقسامات الخطرة”.
وبناء على ما سبق لا يُمكن قراءة القرار بوصفه تمسكًا ميكانيكيًا بالعقوبات لمجرد الرغبة بالعقاب، بل هو تمسك مشروط بأدوات الضغط، بانتظار خطوات حقيقية من الجانب السوري لإثبات اختلاف المرحلة.
ويشير الحافظ في حديثه لـ”الترا سوريا” إلى أن “العقوبات ستبقى، لا لأنّ واشنطن تريد ذلك في حدّ ذاته، بل لأنّها ترى أنّ البديل الانتقالي لم يبرهن بعد على استحقاق رفعها، سواء في ملف السلاح، أو في ضمان الأمن الداخلي، أو في تقديم بنية حكم قابلة للاستدامة”.
ومن جهة أخرى، جاء التجديد لحالة الطوارئ بالتزامن مع انفتاح أوروبي محدود تجاه السلطة الانتقالية السورية، ما يستدعي علامات استفهام حول المغزى والتوقيت، ويرى الحافظ أن الانفتاح الأوروبي “لا يعكس بالضرورة موقفًا أميركيًا مماثلًا”.
ويضيف بأن السياسة الخارجية الأميركية أكثر تحفظًا في منح الاعترافات والشرعيات، خصوصًا حين يتعلق الأمر بملفات معقدة كملف سوريا، الذي ينطوي على أبعاد أمنية، عسكرية، وتحالفية شديدة الحساسية، بينما تميل أوروبا، بحكم موقعها الجغرافي وقلقها من موجات اللجوء ومن تمدد الفوضى الإقليمية، إلى اتخاذ خطوات براغماتية في الانفتاح، لكن واشنطن لا تزال ترى أنّ الانفتاح يجب أن يُبنى على اختبارات صارمة، منها ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل.
ومن هذا المنطلق، لن يتجه مستقبل العلاقة بين دمشق وواشنطن بسرعة نحو التطبيع أو الاعتراف، بل سيبقى مرهونًا بتحقق شروط ملموسة. ويوضح الحافظ أن هذا “الأمر ليس مرتبطًا فقط بمزاج الإدارة الأميركية، بل بنظرتها إلى توازن القوى الإقليمية، وتصوراتها حول دور سوريا المستقبلي”.
صفقة غير ناجزة
الحديث عن تجديد حالة الطوارئ يقود إلى السؤال التالي: هل عدم الاعتراف الأميركي بالعهد الجديد مرتبط فعلًا بتحقيق المطالب الأميركية المعلنة، أم بصفقة ما تتم خلف الكواليس ربما ترتبط بملف العلاقات السورية مع تل أبيب؟
وفي معرض الإجابة على هذا الاستفسار، يقول مالك الحافظ إن “واشنطن تضع شروطًا واضحة في بياناتها الرسمية، لكنها أيضًا تتعامل ببراغماتية شديدة خلف الكواليس”، موضحًا أن “علاقة السلطة السورية الجديدة بإسرائيل ستكون بلا شك في صلب الحسابات الأميركية، خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية الكبرى التي نشهدها، مثل تقارب إسرائيل مع دول الخليج”.
ويتابع: “الإدارة الأميركية تراقب بدقة كل ما يدور في قنوات الاتصال غير الرسمية، سواء عبر وسطاء إقليميين مثل الأردن وتركيا، أو عبر مسارات أمنية غير معلنة. لكنها حتى الآن لا ترى في السلطة الانتقالية طرفًا موثوقًا أو ناضجًا بما يكفي لعقد صفقة واضحة المعالم. هناك دائمًا فرضية تحريك ملف العلاقة السورية ـ الإسرائيلية كـ”عملة” سياسية، لكنها في هذه اللحظة ما تزال بعيدة عن أن تصبح صفقة ناجزة”.
الترا سوريا
———————————
=========================