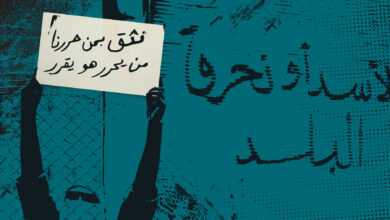استعادة الثقافة الدستورية في سورية: راهنية “دستور 1920” الآن/ محمد م. الأرناؤوط

11 مايو 2025
لم يعد الوضع في سورية يشي بطمأنينة لما هو آتٍ في ظل مخارج “الحكم الانتقالي” في الأسابيع الأخيرة التي تلت مجازر الساحل والتحشيد الطائفي وصولًا إلى ضواحي دمشق (جرمانا وصحنايا). وكان من المفارقات هنا أن صحنايا التي شهدت افتتاح “منتدى رياض سيف” في عام 2001، الذي شهد حضورًا كثيفًا يعبّر عن هوية وطنية سورية متعطشة لحكم ديمقراطي، تتحول الآن إلى ساحة للاقتتال الطائفي، ولذلك كان لا بد من الانتقال إلى الضاحية الشمالية لدمشق (قدسيا) لإعادة افتتاح “منتدى رياض سيف” الذي له رمزيته الآن.
بعد المفاجأة المختلطة بالنشوة من سقوط النظام الأسدي للأب والابن الذي حكم سورية حوالي 55 سنة، أي ما يعادل نصف حياة الدولة السورية بشتى حكامها (1920-2024)، كانت الأنظار تتجه إلى “القوة المحررة” ووعودها الكثيرة. كانت النشوة بالحرية والديمقراطية المنتظرة والمواطنة الحقة تسمح بانتظار المزيد من الوقت لتحقيق الوعد. ولكن ما حدث لاحقًا على أرض الواقع من تجاهل المكونات المدنية والعسكرية المعارضة للحكم الأسدي (الموجودة في الداخل والخارج)، والتوجّه إلى حكم استئثاري من خلال حكومة تصريف الأمور ثم تسمية الرئيس الجديد للدولة والحوار الوطني والإعلان الدستوري المستعجل الذي أرسى نظام حكم جديد لا مثيل له بين الجمهوريات العربية أدى إلى استعجال الأكراد إلى عقد مؤتمرهم الوطني في القامشلي، الذي أرسى قاعدة من قواعد دستور 1920 ووضع الحكم الجديد أمام فرصة استثنائية: تعديل الإعلان الدستوري وطرح تصور جديد لنظام حكم مطمئن أكثر لمكوّنات الشعب السوري ويخرج البلاد من الخطر الذي يحدق بها.
لماذا الخوف من الدولة المدنية واللامركزية
كان إسقاط الحكم الأسدي في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لاستعادة مكوّنات الوطنية السورية كقاعدة لهوية سورية جامعة ودولة ديمقراطية جديدة تعيد سورية على الأقل إلى بداية ستينات القرن العشرين عندما كان مستوى الدخل فيها أعلى من كوريا الجنوبية، التي أصبحت الآن حاضرة في أحلام بعض السوريين.
من هذه المكوّنات للهوية الوطنية السورية كان إعلان الحكومة العربية في دمشق عام 1918 عندما كانت الدولة العثمانية لا تزال تترنح، والتئام المؤتمر السوري في صيف 1919 الذي تحوّل إلى مجلس تأسيسي بعد أن كُلف بوضع دستور جديد للبلاد، وإعلان استقلال “المملكة السورية” في 8 آذار/ مارس 1920 من على شرفة بلدية دمشق المطلة على ساحة المرجة، الذي أطلق النقاش لاستعجال إقرار بنود الدستور الجديد إلى حين اقتراب القوات الفرنسية من ميسلون حيث جرت المعركة في 24 تموز/ يوليو 1920. وعلى الرغم من دخول القوات الفرنسية إلى دمشق في 25 تموز/ يوليو 1920 بقي الاحتفال بيوم 8 آذار/ مارس قائمًا في السنوات التالية سواء في سورية أو في الأردن (الذي بقي ضمن الإدارة السورية حتى صيف 1920) حتى 1962. ففي 8 آذار/ مارس 1963 حدث الانقلاب العسكري على النظام الدستوري القائم وسمّي لاحقًا باسم “ثورة 8 آذار”، وأصبح الاحتفال به يتزايد على الرغم من سوء مصير الذين قاموا به في 1963.
ومن هناك كتبتُ وتمنيتُ أن تقوم الحكومة الجديدة أو مكونات المجتمع المدني الافتراضي باستعادة هذه اللحظة التاريخية وتعيد الاعتبار إلى 8 آذار/ مارس الأصلي باعتباره “يوم إعلان استقلال سورية”، مما يلفت أنظار الأجيال الجديدة (التي غُيّبت تمامًا عنه) إلى هذا اليوم واستتباعاته: دستور 1920 الذي يمكن اعتباره، برأيي، أول وأفضل دستور عربي بالنسبة إلى ذلك الوقت.
وكان النظام الأسدي على مدى 55 سنة قد غيّب تمامًا يوم 8 آذار/ مارس 1920 ودستور 1920، ولم تشارك المؤسسات الأكاديمية المنضوية تحت جناحه في أي نشاط استذكاري للحكومة العربية والاستقلال السوري أقيم في الدول المجاورة (الأردن ولبنان). والأسوأ من ذلك أن النظام سمح بهدم المبنى الأثري لبلدية دمشق الذي أعلن من شرفته الاستقلال السوري في عام 1920 عوضًا عن أن يحوله إلى “متحف الاستقلال السوري”.
في دستور 1920 كان نظام الحكم الجديد الذي وضعه آباء الدستور السوري بالاستناد إلى أحدث الدساتير الموجودة آنذاك، يتضمن في البنود الأولى ثلاثة مبادئ مهمة بالنسبة إلى وضعنا الحالي:
(1) حكومة مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام.
(2) تتألف الحكومة السورية من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزئة.
(8) الوزارة مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي العام.
ويلاحظ في الدستور أنه خصّص الفصل الحادي عشر بكامله (مواد 123-145) عن اللامركزية التي تستند إلى “المقاطعات” التي تسمح للخصوصيات أن تعبّر عن نفسها. ولدينا هنا ثلاثة بنود ملهمة:
(123) تُدار المقاطعات على طريقة اللامركزية الإدارية الواسعة في إدارتها الداخلية ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة.
(124) لكلّ مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة حسب قوانينها ونظاماتها المحلية ووفقًا لحاجاتها.
(125) يُشترط في أساس تقسيم المقاطعات على ألا تقل مساحة كل مقاطعة عن خمسة وعشرين ألف من الكيلومترات المربعة وألا يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف، وأن تراعى فيها الارتباطات الطبيعية والاقتصادية.
وإذا ما أخذنا التغيرات الديموغرافية في سورية خلال مائة سنة يصبح من السهل تصوّر النظام اللامركزي المطروح الآن، في الوقت الذي يعتبر البعض كل حديث عن الدولة المدنية واللامركزية بدعة وكأنّ الغالبية المسلمة في سورية في عام 1920 مع الشيخ المعمّم رشيد رضا، رئيس المؤتمر السوري الذي كان يدير جلسات إقرار بنود الدستور، كانت “خارج السكة”.
وفي هذا السياق، وانسجامًا مع اتفاق الشرع- عبدي الذي اُستقبل بآمال كبار، لا توجد مشكلة في أن تتضمن “الحقوق الدستورية” للأكراد اعتبار اللغة الكردية “لغة وطنية” ضمن تعديلات الإعلان الدستوري، وأن يكون من حق الأكراد أن يتعلموا اللغة الكردية في مدارسهم وأن تكون لهم وسائل إعلام في اللغة الكردية مع كون اللغة العربية “لغة رسمية” حسب دستور 1920. وعلى ذكر هذا الدستور فمن المأمول في تعديلات الإعلان الدستوري أن تكون هناك إشارة إلى دساتير سورية خلال 1920-1950 حتى يعزّز الدستور الدائم الهوية الوطنية السورية الجامعة.
ضفة ثالثة