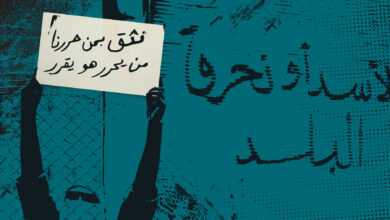الطريق الثالث.. الوطنية السورية ضرورة لا ترف!/ حسان الأسود
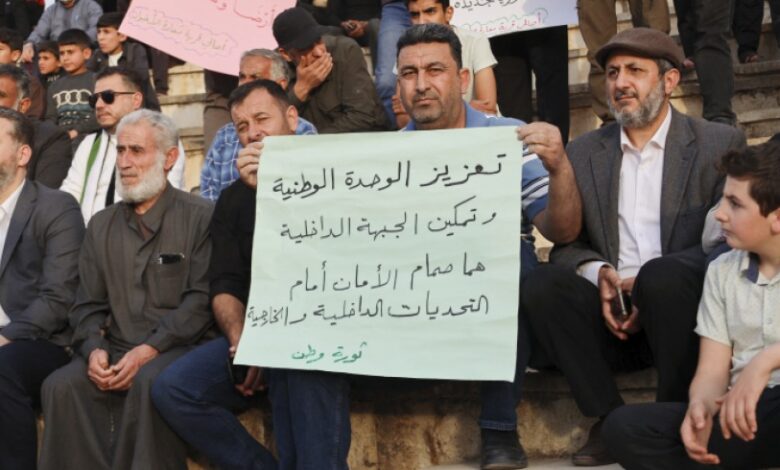
2025.05.11
“الوطن ليس ترابًا فحسب، بل هو ذاكرة وكرامة.” هكذا تكلّم ميخائيل نعيمة (17أكتوبر.1889- 28فبراير 1988)، وربّما يكون كلامه هذا وصفًا ملائمًا الآن لاسترجاع بعض التوازن لخطابنا السوري المتشنّج والموتور. فمنذ سنوات دخلنا في صراع ليس ضدّ النظام الدكتاتوري المقيم على صدورنا فحسب، بل وضدّ بعضنا فرادى وجماعات، وفي طريقنا سحقنا الوطن والهويّة والتاريخ إضافة للجغرافيا والديمغرافيا. نحن السوريين الواقفين على نبرة والموقدين النار تحت كلّ قدور الطبخ، إلا قِدْرِ طبختنا الوطنية التي ما زالت طبخة بحص، لم يعد يصدّق حتى الأطفال أنّها ستشبعهم وتملأ بطونهم الفارغة.
منذ قرن مضى، لم يكن لنا ترف اختيار طريقنا بحرّية نحو وطن يجسد طموحاتنا وهويتنا. والتاريخ هذا شهد محطات قاسية، تداخلت فيها عوامل الاستعمار والاستبداد، لتُغيّب أي فرصة لبناء دولة مستقلة ذات سيادة. كنّا فريسة ضعفنا الذي ورثناه عن الرجل المريض المنهار تحت ضربات الأقوياء، وكانت بلادنا في مركز زلزال التغييرات الدولية آنذاك، فلم يُسمح لنا باستكمال التجربة الأولى التي ابتدأت مع تشكيل المملكة العربية السورية إثر دخول قوات الشريف حسين دمشق. هكذا سرق الغرب من العرب، ومنّا نحن السوريين بالأخص، أوّل ديمقراطية، أو أوّل محاولة لبناء ديمقراطية على الأقل. هكذا حطّم أوّل تحالف بين الليبراليين والإسلاميين الساعين لبناء دولة مستقلّة ذات سيادة وديمقراطية في الوقت ذاته، وتقوم على جوهر أساسي هو اللامركزية. لقد كان الدستور المحطّم الذي أسقطه الانتداب الفرنسي أوّل وثيقة سورية، بل عربيّة، تؤسس لتشاركية قائمة على حكم لا مركزي يأخذ أوضاع أجزاء المملكة الدستورية آنذاك بعين الاعتبار، من فلسطين إلى الأردن إلى لبنان، التي كانت كلها جزءًا من المملكة السورية الوليدة. هكذا كتبت إليزابيث تومبسون، وسيكتب كثيرون غيرها لاحقًا.
واليوم، وبعد مضيّ قرنٍ ونيّف على ذلك التاريخ، وبعد أن صار الحفاظ على التقسيم الاستعماري هدفًا بذاته، لا لمحبتنا به، بل لخوفنا من تقسيم جديد أكثر حدّة ودموية وشرًّا، ووسط الانقسامات والتجاذبات والصراعات والتناحرات الكبيرة، وخاصّة ما يحصل في الساحل وريف حمص وحماة الغربي وما يحصل في جرمانا وصحنايا والسويداء، ووسط الغموض الذي يلفّ مصير مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تبدو الوطنية السورية أكثر من مجرد شعار؛ إنها ضرورة مصيرية للحفاظ على الإنسان قبل الأرض، فالأرض تبقى، وما يتغيّر هو الحدود السياسية التي تفرّق البشر أو تجمعهم. قد يجد كاتب هذه السطور مثلًا نفسه أقرب لابن الرمثا وإربد جغرافيًا واجتماعيًا ربّما من ابن دمشق أو حمص أو حلب أو إدلب، وهذا ليس تفضيلًا لهذا على أولئك، بل لأنّ الجغرافيا لها أحكامها التي لا تستطيع السياسة القفز عليها مهما تطاول الزمن.
بعد الثورة عام 2011 لم يطل الأمل كثيرًا، فسرعان ما تحولت الساحة السورية إلى مسرح لصراعات القوى الكبرى، مما أدى إلى تشظي الهوية الوطنية أكثر فأكثر. وبدلًا من تعزيز الوحدة، انكفأت الجماعات المختلفة إلى هويات فرعية طائفية وعرقية وحتى مناطقية. لكن هل نحن الوحيدين في العالم حتى نجرّب كل شيء ونبدأ دومًا من النقطة صفر؟ ألا يمكننا الاستفادة من تجارب ملهمة استطاعت فيها شعوب ممزقة أو مدمرة أن تُعيد تعريف نفسها وتبني هويات وطنية جامعة؟ الجواب نعم بكل تأكيد، ولنأخذ تجربتي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وجنوب أفريقيا بعد الأبارتايد بعجالة واختصار شديدين.
عقب هزيمتها الساحقة في الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا دولة مدمرة مادّيًا ومنهارة معنويًا. كان المجتمع الألماني متورطًا في واحدة من أكثر الأيديولوجيات عنفًا وتطرفًا في التاريخ الحديث، النازية. لكن التجربة الألمانية أظهرت كيف يمكن لشعب أن يُعيد بناء وطنه على أسس جديدة من الاعتراف والمساءلة والمصالحة. اعترف الألمان بداية بالواقع والجرائم التي ارتكبوها، وصحيح أنّهم خارجيًا نقلوا جزءًا كبيرًا من نتائج إحساسهم هذا بالذنب تجاه اليهود، وألقوه على عاتق العرب، عندما أسهموا بقوّة لا مثيل لها في بناء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، إلا أنّهم داخليًا رسخوا ثقافة الاعتراف بالذنب بعد أن حُوكم كبار مجرميهم النازيين في نورنبرغ. ثم أعادوا كتابة التاريخ القومي بعيدًا عن الأساطير العنصرية، وأعادوا بناء التعليم والإعلام وعززوا قيم الديمقراطية والعدالة. هكذا تمّ بناء هوية وطنية جامعة على أساس الدستور الجديد (Grundgesetz) الذي كرّس حقوق الإنسان والحرية والمواطنة المتساوية، ولم يعاندوا ويصرّوا على الإنكار أو التغاضي، بل تجرّأوا في مواجهة الحقيقة، والتأسيس على قيم جديدة.
أمّا جنوب أفريقيا التي خاض شعبها تجربة فريدة في تسعينيات القرن العشرين، فهي مثالٌ آخرٌ على إمكانية تجاوز الانقسام العرقي العميق من خلال مقاربة وطنية جامعة. بعد عقود من نظام الفصل العنصري، لم تلجأ جنوب أفريقيا إلى الانتقام، بل إلى العدالة الانتقالية من خلال لجنة الحقيقة والمصالحة التي رأسها الأسقف ديزموند توتو. فماذا فعلت هذه اللجنة؟ لقد اتبعت نهجًا واضحًا سار وفق خطوات مدروسة ليحقق الاعتراف العلني بالجرائم مقابل العفو، مما سمح بتفكيك البنية النفسية والعنفية للنظام السابق من دون حرب أهلية. وكان وجود القائد العظيم نيلسون مانديلا، فرصة لبناء قيادة وطنية استثنائية، شملت البيض والسود معًا. كرّس هذا كلّه عقدًا اجتماعيًا جديًا بُني على المساواة والعدالة وأعاد الثقة بين المكوّنات المختلفة للشعب، أو على الأقل أسس لتلك الثقة على أرضية راسخة وصلبة.
فماذا يمكننا أن نستفيد من هاتين التجربتين؟ يمكننا أن نتعلّم أن إعادة بناء الهوية الوطنية ممكنة حتى بعد الحرب والدمار، شرط أن تُبنى على الاعتراف والعدل والمشاركة وأن ندرك أنّ الثأر والتغاضي وجهان لعملة واحدة، الهروب من المساءلة لا يصنع وطنًا، كما أن الانتقام لا يبني عدالة. وأنّ القيادة التي ترفض الإقصاء وتؤمن بالحوار هي شرط لازم لأي مشروع وطني ناجح. “من لا يقرأ التاريخ يُجبر على تكراره.” أمام هذه اللوحة القاتمة، يبرز “الطريق الثالث” خيارًا لا بديل عنه، يتجاوز ثنائية الاستبداد العسكري والانغلاق الديني. هذا المشروع السوري الذي يجب أن يقوم على الحوار والانفتاح بين جميع المكونات من دون إقصاء، وعلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون. مشروع يرفض إعادة إنتاج الدكتاتورية بكل أشكالها (عسكرية، دينية، عائلية أو فردية). ويعيد تعريف الوطنية السورية كعقد اجتماعي طوعي يعترف بالتنوع ويُعزز المواطنة.
كما فعل الألمان، وكما فعل الجنوب أفريقيون، فإننا قادرون على صوغ هويتنا وبلدنا ودولتنا من جديد، لا على قاعدة النفي والإقصاء، بل على أساس الاعتراف المتبادل، والمشاركة الحقيقية، والعدالة الجامعة. ليست الوطنية السورية رفاهية يمكن تأجيلها، بل هي شرط البقاء ومعيار التحرر. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يُعيد بناء الإنسان والمجتمع والدولة على أسس العدالة والمساواة والحرية. وحده “الطريق الثالث”، طريق التشاركية والانفتاح، قادر على إخراج سوريا من نفق الاستبداد والانقسام، نحو دولة لجميع مواطنيها من دون استثن
تلفزيون سوريا