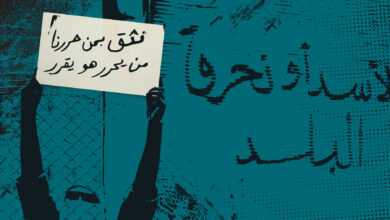نعمة الطوائف ونقمة الطائفية: في العقد الاجتماعي وقلق الهوية السورية/ محمد خالد شاكر

13 مايو 2025
لم يشهد التاريخ السوري فرزاً دوغمائياً نكائياً طائفياً أكثر مما يشهده اليوم؛ فلم تعد الطائفية في سورية خطاباً شعبوياً على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بقدر ما تحولت إلى حالة مرعبة، أصبحت تتسلّل رويداً رويداً إلى الخطاب السوري، إعلامياً، وثقافياً، وسياسياً.
قبل تأصيل ظاهرة تصاعد الخطاب الطائفي بسبب عدم تبلور الهوية السورية، تاريخياً، في إطار عقد اجتماعي يعكس تعدّدية المجتمع؛ لابد من التعريج على أسبابه المباشرة التي ولدت من رحم صراع دموي ومدمّر، فالتحوّلات القسرية التي طرأت على المجتمع السوري خلال سنوات الحرب 2012- 2024، دفعت بالشخصية السورية المذعورة إلى الانكفاء على خصوصيّتها ردّ فعل للواقع المحتدم؛ فتحول المجتمع السوري المسالم والمتآلف إلى خاصرة رخوة من الخوف والانقسام والتشظي طائفياً، وإثنياً، ومذهبياً، وسياسياً، وعسكرياً.
وكما تفرض التعدّدية السياسية نفسها ميزة لتعزيز قيم العدالة والحكم الرشيد في مواجهة الاستبداد، تشكل المجتمعات المتعددة طائفياً وإثنياً إحدى ميزات المجتمعات المتحضرة اليوم، وذلك من خلال حوكمة مؤسّساتها، التي تضطلع بصهر الهويات الفرعية في بوتقة الدولة الوطنية، فكلما أحسنت السلطات الحاكمة إدارة التنوّع والاختلاف، نجحت في إدارة التنوّع ونقلته من تعدّدية الصراع إلى تعددية التوازن والتكامل.
تواجه المؤسّسة الثقافية السورية اليوم المهمّة الأكثر إلحاحاً في طريق بناء الدولة السورية، وذلك في قدرتها على مواجهة الخطاب الطائفي الشعبوي المنفلت، وانتشال العقلية السورية من إرثها الثقيل المحمّل بعقود من القهر والخوف والموت والاستبداد.
لقد أصبحت الطائفية وجبة شهية مادتها الكراهية والتشفي والانتقام، فطفت على السطح مفردات الضد من الوطنية، كتسفيه الاعتقاد والخصوصية الدينية، والحديث عن تاريخية هذه الطائفة، وغموض تلك، ووصف هذه الطائفة بالغلو والكفر؛ يؤازرها سرديات لي عنق التاريخ من خلال الحديث عن علاقة هذه الطائفة بالمحتل الفرنسي، وربط تلك الطائفة بالنظام البائد، والأخرى بإسرائيل، قابله انكفاء على الخصوصية، أدّى إلى تصاعد حمّى الهويات الفرعية؛ وكأن السوريين يتجهزون لمرحلة ملوك الطوائف، في مرحلة أحوج ما يكونون فيها إلى وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة السورية، وبلورة هويتها الوطنية الجامعة.
يرى جان جاك روسو ( 1712- 1778) “أن البشر مسالمون بطبيعتهم، لكن القوانين والمؤسّسات هي التي تفسدهم” في إشارة إلى طبيعة العقد الاجتماعي أو الدستور الذي يحكم الأفراد والجماعات، وبالأدق قدرة السلطة والقوانين على إيجاد آلية للالتزامات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، بوصفها علاقة جدلية تؤدّي، في نهاية المطاف، إلى تحقيق الإرادة العامة، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، فلا دولة بدون سيادة، ولا سيادة بدون إرادة عامة مشتركة، ولا إرادة عامة بدون عقد اجتماعي يعكس تطلعات الجميع.
أدّت التطورات التاريخية لفكرة الدولة بعد مؤتمر وستفاليا (1648) إلى إنهاء الحروب الدينية في أوروبا، وحل المشكلة الطائفية. كما أدّت التطورات التاريخية لمفهوم الديمقراطية والهزات التي عانتها أوروبا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الانتقال من فكرة الدولة القومية إلى دولة المواطنة حلّاً لإشكاليات الهويات الفرعية وصراعاتها، فأصبح الفرد وبغض النظر عن خصوصيته مواطناً له الحق في أن يكون له وطنٌ، لا يعيش فيه فحسب، وإنما يشارك في بنائه.
أسّست فكرة المواطنة لتدوين الحقوق الطبيعية، أو ما يسميها بالمفهوم الإيكولوجي عالم العقائد توماس بيري ( 1914- 2009) بـ “شريعة الأرض”، أي الحقوق التي تولد مع الإنسان وفي بيئته، ومنها الحقّ في الحياة والوجود، والحقّ في الحرية، والحق في التعبير، والحقّ في الكرامة، والحق في الملكية، بوصفها حقوقاً متأصلة في النفس البشرية وموجودة في مراحل ما قبل الدولة، ومن ثم، لا يحقّ لأية سلطة مصادرتها أو النيْل منها.
عرفت سورية أولى إرهاصات تشكيل الهوية الوطنية خلال فترة الحكم العثماني، عندما أسّس بطرس البستاني ( 1819- 1883) صحيفة “نفير سورية” أول صحيفة وطنية، كما أسّس “المدرسة الوطنية العليا” التي ضمّت طلاباً من جميع الطوائف.
منذ تأسيس الدولة 1920، لم تشهد سورية أي حراك جماهيري يعكس الممارسة الفعلية لديمقراطية قادرة على بلورة هوية سورية نابعة من فكرة سيادة الشعب. ولهذا، لم تعرف سورية حكومة وطنية بشرعية شعبية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فقد كانت غالبية الحكومات السورية نتاج تحالفات كولونيالية. على سبيل المثال، ضمّت الوزارة الأولى بعد إعلان الاستقلال في مارس/ آذار 1920 مجموعتين، هما مجموعتا رضا باشا الركابي الموالي للإنكليز وعلاء الدين الدروبي الموالي للفرنسيين، تزامن ذلك مع تشكيل برلمانات بديمقراطية هشّة، أوصلت المتنفذين، والباشوات، والإقطاعيين، والتجار، وشيوخ العشائر من جميع الطوائف والإثنيات.
طوال فترة الاحتلال الفرنسي، استمر استنساخ الأزمة البنيوية للهوية السورية نتاجاً كولونيالياً، فتشكّلت هوية سياسية نخبوية هي الأخرى من تجّار المدن، وكبار ضباط الجيش العثماني السابقين، والإقطاعيين، وشيوخ القبائل، والأشراف، ورجال الدين، والوجهاء، بصفتها تركيبة غير متجانسة هوياتياً بالمعنى الوطني، تجمعها، أفقياً، المصالح وتقاسم السلطة، بينما تغيب، عمودياً، الجماهير السورية؛ في دولةٍ صُممتْ بالأساس بطريقة استعمارية، بحيث يصعب على أية دولة خارجية الانتصار فيها وحدها، كما يصعب على أي طرف سوري الاستئثار بها داخلياً. وهو ما يفسّر بقاءها محكومة بثنائية الانقلابات والاستبداد، كما هشاشتها في مواجهة التحديات الخارجية، بسبب متواليات القضم الجغرافي من أجزائها منذ الاستقلال.
مع انقلاب 1970 الذي أسس للمرحلة الأسدية 1970- 2024 جرى من جديد، وبطريقة ما، استنساخ التحالف الكولونيالي ذاته للهوية السورية، بوصف ذلك تركيبة جاهزة للاستئثار بالسلطة، حيث عقدت السلطة في مرحلة الأسد الأب وابنه تحالفاتها مع كبار التجار في تزاوج خبيث بين المال والسلطة، كما أعادت صياغة المشيخة من داخلها على أسس ولائية، وأفرغت العقيدة العسكرية للجيش واستبدلتها بالأجهزة الأمنية؛ فتحوّلت سورية إلى دولة عسكرتارية شمولية، تئن فيها جميع الطوائف والإثنيات تحت وطأة الولاء للسلطة، الذي نقل الهوية السورية من مرحلة القلق إلى الإلغاء، فعاشت سورية حكماً بوليسياً يخفي تحت رماده، جمر الصراعات البينية سياسياً، وطبقياً، ومناطقياً، وطائفياً، وعشائرياً، وهي التصدّعات التي أسّست في مراحل لاحقة لانفجار مجتمعات المخاطر في مارس/ آذار 2011.
أدّى تحوّل الثورة السورية إلى صراع طائفي مخيف وبدفع خارجي إلى تصاعد الهويات الفرعية السورية، وبالأخص المذهبية منها، ما دفعها إلى الانكفاء على خصوصيتها حالة طبيعية في النفس البشرية خلال الأزمات. وتصاعدت المسألة الطائفية أكثر مع سقوط النظام، خصوصاً مع رفض آليات إدارة المرحلة الانتقالية، التي رأت فيها باقي الطوائف وبعض الكرد، وكثير من النخب السنية، استئثاراً لسلطة دينية سنّية بعينها، تجافي تطلعات السوريين في التشاركية والمواطنة. وهو الموقف الذي يأخذ بالتزايد بين السوريين يوماً بعد، خصوصاً بين قوى المعارضة من السياسيين والعسكريين والمدنيين المنشقين عن النظام، الذين بدؤوا يشعرون بأنهم فئة غير مرغوب فيها في عقلية الحكم الجديد، ما يضع سورية أمام حالة من اتساع دوائر الانقسام السوري طائفياً، وإثنياً، وسياسياً.
يقف السوريون اليوم أمام استحقاقٍ أخير مهم ومفصلي، متمثلاً في الهيئة التشريعية ولجنة صياغة الدستور في مرحلة قلقة وهشّة يقف فيها الجميع أمام خطر وجودي؛ ولحظة تاريخية يجدُر بهم اقتناصها لإعادة صياغة هويتهم السورية من خلال البحث عن مشتركاتهم التاريخية، بدءاً من الأخذ بنعمة التعدّدية في المجتمعات المتحضرة، والتوجه إلى ما هو جامع. فهم عرب من مسيحيين وعلويين ودروز وسنة، وهم مسلمون من كرد وعرب.
سورية اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى دستور عصري يؤطّر الهوية السورية، ويصوغ عقدها الاجتماعي في إطار دولة المواطنة، الكفيلة وحدها بإبعاد غول الطائفية الذي يطلّ برأسه على جميع السوريين، وفي أضعف حالاتهم من الجوع، والخوف، والدمار، والانقسام. وهي المهمّة التي تبدأ من ثورة ثقافية بخطاب سوري جامع، يطفئ نار النكايات الطائفية قبل أن يكتوي بها جميع السوريين.
العربي الجديد،