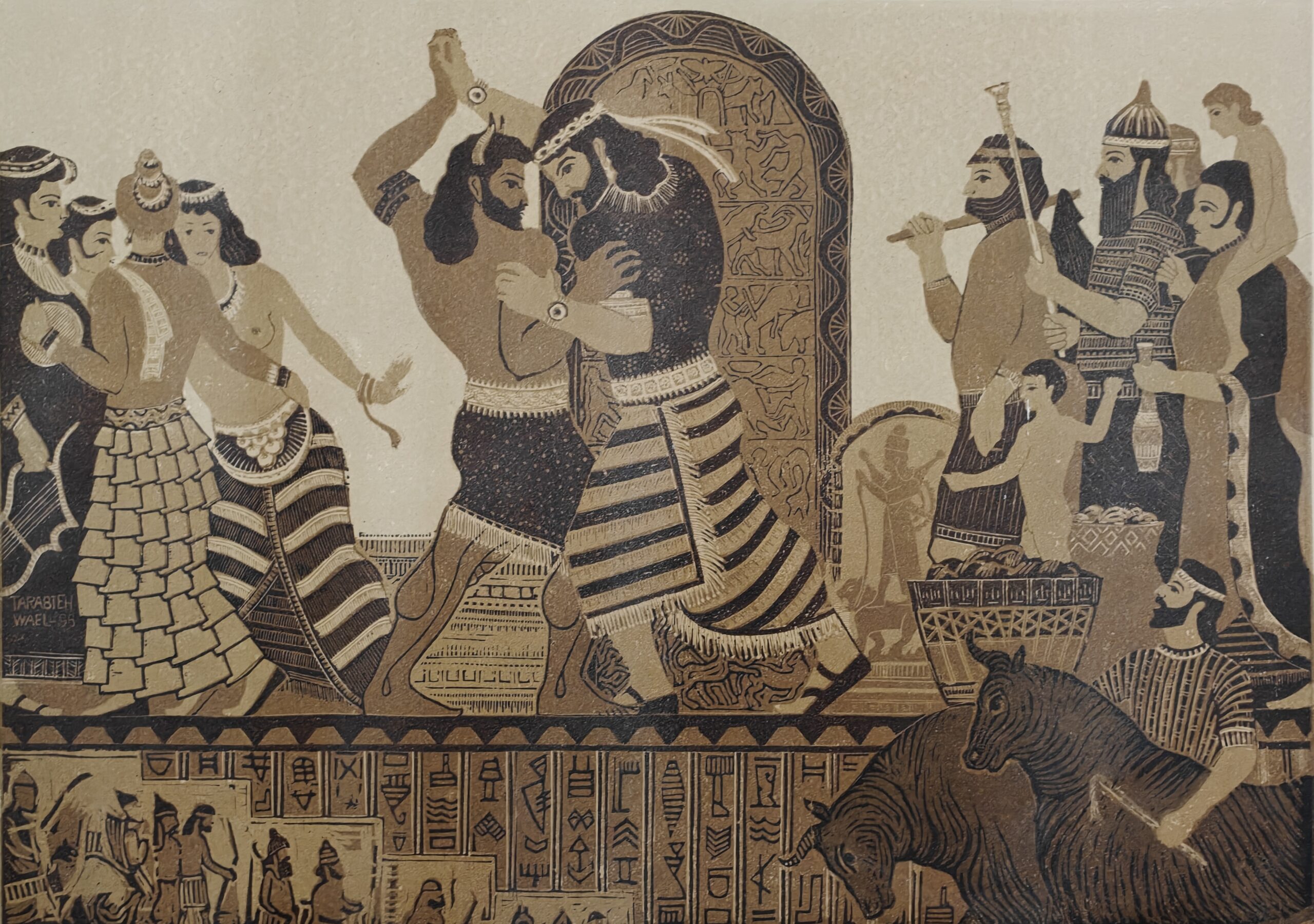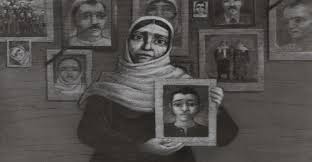سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 19 أيار 2025
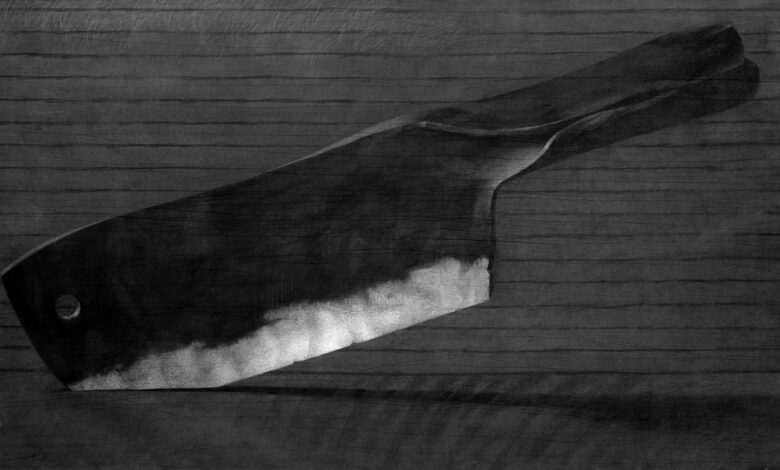
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————-
عندما تخذُلنا الركاكة السياسية/ مازن علي
18 مايو 2025
لأن السياسة ليست اختياراً طوعياً يمكن الابتعاد عنه أو تجنّبه، ولأن السياسة تحدّد مستوى التعليم والطبابة التي نتلقاها، بل جودة الهواء الذي نتنفّسه، ولأنها تتدخّل في شروط الحياة، بدءاً من أدنى الحاجات إلى أعمق معاني المواطنة والحرية، فإننا لا نستطيع الإفلات منها ومن تأثيرها على واقعنا ومصيرنا، تماما كما لا نستطيع الإفلات من المناخ الذي نعيش فيه، على حد تعبير روبرت دال. لهذا؛ عندما تختلّ السياسة أو تتعطّل، لا يظل أثرها حبيس الجدل النظري، بل يلقي بثقله على تفاصيل الحياة اليومية.
هذه مقدّمة مبسطة ومختزلة لمعنى السياسة التي تصفع وجوهنا بتداعياتها وانعكاساتها على واقعنا مع كل تصريح أو قرار يصدر عن السلطة السورية الحالية، فبعد مرور نحو ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، تستخدم السلطة خطاباً سياسياً ينطوي على وعود مُعلّقة التنفيذ، وإجراءات غير قابلة للصرف السياسي، شهدنا تجلياتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنجز على عجل، في مشهد بروتوكولي أكثر منه آلية حقيقية لإنهاء الصراع أو الاستماع إلى المكوّنات المتضرّرة. مثله، الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر من دون مشاوراتٍ مجتمعية كافية، وأهمل المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي؛ كالمشاركة السياسية والتمثيل العادل. سبق ذلك تسريح آلاف الموظفين تحت ذرائع الفلول أوالعمالة الزائدة، من دون البحث في تداعيات ذلك على مؤسّسات الدولة، وما تُحدثه من توترات اجتماعية بمظلومية مضافة إلى الجرح السوري لتبقيه مفتوحاً، ما عزّز الريبة في دوافع السلطة الجديدة.
أضف إلى ذلك إعادة إنتاج شبكة زبائنية جديدة من المحسوبين على دوائر السلطة، في التعيينات والترقيات، وجدل المقاتلين الأجانب، ما أفرغ الوعود من محتواها، وأعاد تدوير النخبة الوافدة إلى دمشق بعد إسقاط نظام الأسد، بدل فتح المجال أمام الطاقات الوطنية المعطّلة في المؤسسات الأصيلة، ثم جاء تأليف الحكومة تحت يافطة التكنوقراط، لتؤكّد أن أداء السلطة يركز على إدارة الصورة، لا بناء الثقة، واستثمار رمزية التحرير لتبرير احتكار القرار، عبر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس المرحلة الانتقالية.
لا يُراد من كل ما سبق التحامل على التجربة الوليدة في سورية، ولكن ما نعايشه مع السلطة ليس مجرّد ضعف في الأداء، بل صورة أوضح لما يمكن تسميتها الركاكة السياسية، التي لو أردنا تعريفها لفهمناها انطلاقاً من كنايتها اللغوية وإسقاطاتها السياسية؛ فكما أن للّغة أصولاً تضبط المعنى وتمنح العبارة تماسكها، فإن للسياسة منطقاً يحكم الفعل ويمنعه من التشتت والتناقض. والركاكة، في أصل معناها اللغوي، ليست خطأ صريحاً بقدر ما هي ضعف في التكوين؛ جملة لا تعرف أين تبدأ وأين تنتهي، كلمات مترابطة شكلياً، لكنها لا تحمل فكرة واضحة. وعلى هذا القياس، تبدو الركاكة السياسية شبيهة بسابقتها، لا تنفي النية الطيبة، ولكنها تكشف عن افتقار إلى الحنكة، والحكمة في اتخاذ القرار. ليست الركاكة هنا فعلاً متعمّداً، بل ارتباكٌ وتلكؤٌ يتنكّر في هيئة الحذر، لكنها، في النهاية، تُنتج الأثر نفسه؛ تآكلاً في المعنى السياسي، وعجزاً عن بناء جملة مفيدة اسمها الدولة.
قد يعطي بعضهم العلامة الكاملة لنجاح السلطة في تسجيل اختراقات على مستوى الدبلوماسية الدولية؛ كالحصول على تعهد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات، التي أثقلت كاهل الشعب السوري، ولكن لا ينبغي أن يُنسى أنها ثمرة جهد هائل بذلته دول إقليمية، وتحديداً الأشقاء العرب في سبيل ذلك؛ لهذا يُعدُّ نسب هذا النجاح إلى كفاءة السياسة الخارجية للسلطة تعبيراً عن ركاكة سياسية مضاعفة، فكلنا يعرف أن المصالح لا تُمنح بتعهد لفظي، ولا تُبنى عبر المجاملات الدبلوماسية، بل تُشتق من الداخل، ومن تماسك المشروع الوطني.
التهافت خلف الاعترافات الخارجية، وتقديم تنازلات لا يعلم المواطنون كلفتها، ولا مواضع المقايضة فيها، يشي بمسار تفاوضي غير شفاف، ويقوض جوهر السياسة التي يفترض أن تكون شأناً عاماً، لا ساحة مغلقة لصفقات النخبة.
الأهم أن محاولة التوفيق بين أطراف دولية كبرى تختلف مصالحها وتتناقض طلباتها تشبه السير في حقل ألغام من دون خريطة وطنية، فمن الصعب، بل المستحيل، إرضاء واشنطن وموسكو وأنقرة وباريس والعرب وغيرهم في آنٍ معاً، من غير تقديم أثمان سيادية أو إيجاد تناقضات داخلية عميقة، بالنظر إلى قائمة الشروط التي قد تفجر السلطة ذاتها. السياسة هنا تتحول إلى حقل توازنات هشّة، لا إلى مشروع واضح لبناء الدولة من الداخل. في حين أن المسار الطبيعي لأي سلطة محمّلة بإرث ثوري، يفترض أن تنطلق من قيمها وشعاراتها التي خرج السوريون من أجلها، بدل البحث عن شرعية خارجية قد تُمنح اليوم وتُسحب غداً.
ما نراه اليوم من أداء السلطة الانتقالية في دمشق ليس سوى امتداد واضح لتلك الركاكة؛ فهي لا تمارس القمع، ولكنها توحي به. لا ترفض الديمقراطية، ولكنها تُسوّف بحجة الوقت، وحساسية المرحلة. ربما ليست مسوّغات خاطئة تماماً، لكنها تبريرات تنمّ عن الافتقار إلى الدربة والمهارة السياسية. تحاول تجنّب الاصطدام بالمطالب والاستحقاقات الملحّة، فإذا بها تصطدم بالواقع. فالأمن ينفلت، والثقة تتآكل، والمجتمع الذي يمنح المقبولية والشرعية يتسلل إليه الخذلان.
لو قُيّض لأهل السلطة فهم أصيل وراسخ للسياسة، لما كنّا أمام جدل بديهيات الحكم والإدارة والمشاركة والتمثيل، بل كنّا نحث الخطا إلى رسم ملامح الدولة المنشودة، المعبّرة عن الإرادة العامة للسوريين، وشكل النظام الذي يوجه السياسات، ومنها يمكن الانطلاق نحو بناء استراتيجية خارجية تلبي مكانة سورية الحضارية وموقعها الجيوسياسي والاستثمار بهما، لتجاوز السنوات المهدورة في عهد النظام البائد.
العربي الجديد
———————————
“سوريا الجديدة”: هذيان “الديمقراطيين” وسحر “البراغماتية” الشائن!/ عمّار المأمون
17.05.2025
الحكومة المؤقتة في سوريا لم تُتح مساحة للسياسة، لا قانون لتنظيم الأحزاب، لا نقابات مستقلّة منتخبة، أما الفضاءات العامّة فتُهدَّد ضمن منطق “فائض القوّة”، فالسلطة تمتلك القدرة على تحريك جموع غاضبة، مستعدّة للقتال، بعضها مسلّح، وبعضها يرفع هتافات إبادية.
“الثورة السورية انتهت”، تعويذة نطقها أحمد الشرع قبل تعيينه رئيساً، ثلاث كلمات مسّت بالسحر عقول الكثيرين وأبصارهم بل حتى أعمتهم، واستسلموا لخطّة الشرع بعد نهاية الثورة، التي تُلخَّص بـ”سندخل منطق الدولة”، تتمّة التعويذة اللازمة كي تكتسب قدرتها الأدائية.
هذه “الدولة” تبنّت الميليشيات التي ائتلفت تحت راية وزارة الدفاع، أما “حكومة الإنقاذ” التي كانت واجهة “هيئة تحرير الشام”، فـ”استلمت” على مؤسّساتها، وظهرت معها كلمات كـ “السيادة”، و”الحوكمة”، و”إعادة الإعمار”، والأهم “سلطة القانون”، تلك التي تختار هذه السلطة حسب مزاجها، ما تنفّذه من “قوانين أسدية”! لكن إلى الآن لم تُجب هذه الدولة ومؤسّساتها عن سؤال: أين تمارس السياسة الآن؟
غموض الإجابة عن هذا السؤال سببه أولاً، تاريخ طويل من فقدان المعنى الذي تسبّب به نظام الأسد، أي الكلمات والمفاهيم على مسافة واسعة من التطبيق والتجلّي المادي، البلاغة الفارغة هذه أعدَتْنا جميعاً، الكلمات على مسافة واسعة من معانيها، مسافة كرسّتها “الثورة” نفسها التي صودرت بسلاح الإسلاميين.
الآن هناك إجابة أقلّ نظرية وأكاديمية، الحكومة المؤقتة لم تفتح مساحة للسياسة، لا قانون لتنظيم الأحزاب، لا نقابات مستقلّة منتخبة، فقط صراخ وشتائم وبيانات على وسائل التواصل الاجتماعي. بصورة ما، لا سياسة الآن في سوريا ولا صوت تمثيلي، طبعاً كلمة سوريا هنا تعني “إقليم بني أميّة”، فلا السويداء، ولا مناطق الإدارة الذاتية محسوبة على دمشق كلياً، أما الساحل فمنطقة شبه محاصرة!
عن بلاغة فائض القوّة
إثر الفراغ البلاغيّ الذي تركه نظام الأسد، تستعير سلطات دمشق من معاجم متعدّدة، معجم الـNGOs (سلم أهلي، عدالة انتقالية، مدنية… إلخ) ومن معجم الميليشيا (خطف، أنفاق، استلام المدن…) وأيضاً تنويعات على معجم الأسد (عناصر غير منضبطة، جماعات خارجة عن القانون وإرهاب… إلخ) ومؤخّراً، أُضيف معجم العداء مع إسرائيل (العدوان الإسرائيلي، وحدة الأراضي السورية، اتفاقيات ابراهام، سلام مباشر…. إلخ) هذه المعاجم التي تلبّي رغبة طيف واسع من السوريين على اختلافهم.
هناك طيف آخر من السوريين لا تحضر الكلمات التي تصفهم، وهم حملُة السلاح، “الفاتحون” على تنوّعهم، بعضهم نظرياً أصبح يخضع لسلطة “الدولة”، والبعض الآخر “عناصر خارجة عن القانون”، وهنا بالضبط تظهر دلالة مصطلح فائض القوّة، فالسلطة (نظرياً) لا تمتلك فقط السطوة على أجهزتها التنفيذية (جيش، أمن عامّ… إلخ) بل أيضاً تمتلك القدرة على تحريك جموع غاضبة، مستعدّة للقتال، بعضها مسلّح، وبعضها يرفع هتافات إبادية.
هؤلاء الذين يمثّلون فائض القوّة، سلطة الدولة عليهم مُلتبسة، هي تمتلك القدرة على تحريكهم بدعوات للنفير العامّ، لا الحدّ من احتشادهم، كلمة واحدة حرّكت فائض القوّة هذا ضدّ العلويين، وضدّ الدروز لاحقاً. هاتان القوّتان، الأولى رسمية تُطالب بالشرعية، والثانية غير رسمية- اعتباطية، تُستخدَم للترهيب الداخلي، تبدأ بجماعة تهاجم كازينو، وصولاً إلى حشود تهاجم مدناً بكاملها، فائض القوّة باختصار هو القدرة على تحريك الجموع المتماهية مع الكلمات السحرية لبلاغة قتل الآخر وإذلاله.
تحريك الجموع، الاحتشاد والهتاف، وأشكال التبجيل والتغنّي، كلّها تُثير الريبة لدى السوريين، لا فقط بسبب إرث الأسد في تحريك المسيرات، بل أيضاً بسبب أشكال المبالغة في الأداء، الذي وصل حدّ دعوات الإبادة في هتافات ما بعد الأسد، الحشد مُريب دوماً، يُثير الشكّ، خصوصاً أن هذه حشود لم تتحرّك خوفاً من المخابرات، بل حماسةً لصدّ الشتيمة المفترضة عن محمد بن عبد الله.
سلطة دمشق تعالج عنف فائض القوّة بـ”تبويس الشوارب”، وأخبار عن اعتقالات للمتّهمين، وتضخيم بلاغة الدولة والقانون، في استعراض للسطوة، على الأقلّ أمامنا نحن السوريين. لكن، أن ينشر المتّهمون بارتكاب جرائم وانتهاكات صورهم وتعليقاتهم على الجريمة! وبعضهم يوثّق جرائمه! إذاً، من تخاطب تلك “الدولة” حين يُناقض “أمرها” الواقع، أي أثر لهذه الكلمات التي نظنّ أن لها قيمة! الشخص الذي قال “كان في قديم الزمان هون مدينة اسمها جبلة… التعن سلافها”، والذي ظُنّ أنه قُتل في اشتباكات مع الدروز، خرج علينا لاحقاً من الماء، كبطل هوليوودي، كحوريَ ماء يقول ساخراً: “فكرتوني متت… بعيدة عن شواربكم!”.
من “نحن الديمقراطيون”؟
منذ سقوط النظام شهدنا واحدة من أكثر الصور الشائنة سياسياً، المعارضة السورية في الخارج (هيئة التفاوض والائتلاف الوطني) هبطت دمشق، وقدّمت الطاعة في القصر أمام أحمد الشرع، لم يعد هناك أي جسد سياسي أو رمزي لمواجهة هذه السلطة، أو يكمّل “ديمقراطيتها” بوصفها تقبل المعارضة، وكأن مفعول الكلمة السحرية “انتهت الثورة”، نجح، وأصبح لـ”أبو محمد” قصر من زُخرف، انتهى الصراع مع الأبد بأمر الجولاني، وسنعود إلى بيوتنا، وسنبني البلد، نحن ديمقراطيون، ومن بقي مسلحون مشبوهون، غير ديمقراطيين، وأحياناً تُلصّق “اللا- ديمقراطية” بـ”قسد” والميليشيات الدرزية!
مشكلة “نحن الديمقراطيون” أن أصحاب هذا الموقف يعيشون وهماً مزعجاً، هذه الفئة التي هُزمت في الثورة، تظنّ أن حسّها المُتعالي بالتفوّق الفكري الذي يُتيح لها “التنازل” و”احتواء” الآخر؛ “الإخوان المسلمين” مثلاً، ومحاورتهم، سيقابله ديموقراطية، أو حسّ وطني، أو تنازل لدى الخصم الذي انتصر، المُحررّ- الجهادي، وهم بأن الخصم سيُشركهم في الحُكم أو السياسة!
لكن من قال إن الهيئة سابقاً، منحت مكرُمَة الحوار و”الديمقراطية” للخصوم؟ ما لاحظناه، أن أشكال المشاركة والمُساسية تُمنَح لأفراد، لا لجماعات، كلّ من حجّ إلى قصر الشعب لأجل صورة مع الشرع، ومن شارك في مؤتمر الحوار الوطني لاحقاً، حضروا فرادى، لا جمعاً ذا ثقل تمثيلي، ومن تمّ تعيينهم ضمن مساحة الحكم، كانوا زخارف، لا قرار لهم في الشؤون السيادية “الداخلية، الخارجية، العدل، والدفاع” عدا الاقتصاد، وربما هنا رهان المتفائلين.
بقيت “الحكومة المؤقتة” صادقة مع نفسها وتاريخها، لم تنطق كلمة ديمقراطية، وأصر “الديمقراطيون” على بناء الدولة، وهذا يُحسَب لهم، وأخذوا مسافة من ماضي الحكّام الجهادي والفصائلي والميليشياوي لـ”بناء الوطن”، ترافقت مع انتقادات على مضض لمهازل مؤتمر النصر ومؤتمر الحوار الوطني، الابتعاد الديموقراطي- البراغماتي، شمل التعامي عن أن السلطة تبيح رفع رايات فصائلية وأحياناً داعشية في الساحات السورية، لكن، “نحن الديمقراطيون” نريد بناء الوطن، ولنأخذ هذه المسافة، وندللّ وهم حُسن النيّة لدى الآخر.
لم تكن المسافة الأولى، أي المسافة من ماضي الحُكّام الجهادي هي الوحيدة، بل خُلقَت مسافة ثانية بعد مجازر الساحل، بوصفها حالة “طبيعية” ضمن مبرر عدميّ يُختصَر بـ”14 عاماً والسوريون يُقتَلون!”، ظهر أيضاً مبرّر آخر لتعميق التعامي، “من يقتل العلويين أجانب” وليسوا سوريين!
تُنزَع الوطنية/ الجنسيّة فوراً عن المتّهم (الذي أوضح الشرع أنه سيجنّسه سورياً) لكن أوضحت الفيديوهات أن المتّهم والمُنتهك سوري، والضحيّة سوري، الأجانب جزء من المشكلة، لا كلّها، البعض وثّقوا جرائمهم بلهجات سورية قحّة! المفارقة، أن هناك وهم مفاده أنه لا يمكن للسوريين أن يقتلوا بعضهم بعضاً بصورة ممنهجة، لكن ألم يعلّمنا نظام الأسد العكس!
المسافة التي أخذها الديمقراطيون، امتدت دماء وخطفاً وقتلاً طائفياً وصل إلى الدروز، لكن لا بدّ من التريّث لبناء الدولة، هكذا هي السياسة ربما، قياس المسافات، وتنازلات مفاهيمية وقيمية و”ثورية” أُخذت من أجل “الدولة”، إلى حدّ التنبيه من ضرورة عدم السخرية من بني أميّة!
وهم البراغماتية والتشابه!
على رغم هذه المسافات من المجازر والجهادية، مساحة عمل “الديمقراطيين” غير واضحة، ولا نتحدّث عن تهديد الحرّيات الخاصّة، لكن صادرت السلطة الفضاء العامّ عبر فائض القوّة والجموع الهاتفة بالإبادة، ومع وضوح سطوة إسرائيل، أُضيف إليهم جموع المتحمّسين لـ”ردع العدو”.
التركيز على وحدة سوريا والسيادة على التراب، والحديث عن شبح التقسيم يُضاف إلى بلاغة بناء الدولة، وهنا السؤال، أي مساحة تُركَت للعب والتنسيق السياسي والتحذلق، منازل دمشق القديمة أم المقاهي؟
السلطة حلّت أحزاباً أقدم من “البعث” نفسه، وتخاطب السوريين الديمقراطيين أفراداً، لكنها تحرّكهم جموعاً! أين مساحة اللعب إذاً؟ صحافة دولية؟ منتدى في منزل؟ بصورة ما، أين يُمارس الديمقراطيون السوريون ديمقراطيتهم؟ النقابات، التي عُيّن نقباؤها تعييناً، ثم اخُتلف على نقيب الفنانين، فأعاد تعيين نفسه بعد حجب الثقة عنه، كونه مُعيّن من “القيادة”؟
انتشر وصف “براغماتي” للإشارة إلى أحمد الشرع، أي أنه قادر على التكيّف مع الظروف وتغيير شكله وخطابه بناء على الوضع القائم، من جهادي عجز عن وضع لغم في العراق فاعتُقل، إلى أمير “داعش” في سوريا، وغيرها من الانقلابات التي انتهت به رئيساً لسوريا يزور فرنسا، ويلتقي بأبناء جلدته في الأنتركونتيننتال في باريس!
لا نعلم إن كانت هذه التحوّلات تسمّى براغماتية، لكن تبنّاها الديمقراطيون أنفسهم، قرّروا أيضاً التنازل والتغيّر لـ”بناء الدولة”، الذي يتطلّب الحضور داخل سوريا، وهذا حقّ وطني، وحلم لا يُنكَر على أحد، لكن إلى أي حدّ يجب أن يقبل الديمقراطيون أنفسهم التنازل والتغيّر؟ أو ما مقدار البراغماتية المطلوبة؟
لا إجابة، لكن تغيّر سلّم أولويات الكثيرين بصورة تُثير الشكّ، إذ نُسيَت حقوق مجتمع الميم، وحقوق المرأة، وتطبيق القانون، والكثير مما طالبت به الثورة نفسها (لا ثورة الجولاني) نُسي الكثير لأجل “بناء الدولة”، التي لم تترك السلطة فيها مساحة للممارسة السياسية بصورة جدّية، استبدل الديمقراطيون الإشارة إلى هذا الغياب، بعاطفة الشوق إلى الوطن، وخطاب مريب: أحمد الشرع يُشبهنا، زوجته تُشبه السوريات! فجأة حلّ تقمّص “القائد” مكان العقل والسياسة!
هذا التشابه مع الشرع ينفيه الغرباء/ المهاجرون، عمر ديابي، الجهادي الفرنسي المقيم في حارم، الذي وصف الشرع بـ”الحرباء”، وبأنه لا يصدّق تحوّلاته، حتى شأن البراغماتية غير واضح أيضاً، إن كان الشرع براغماتياً، فحكومته ليست كذلك، ولو أخذنا قسراً المسافة من ماضيهم الجهادي، والمجازر الطائفية، هناك عجز في إدارة “الدولة”، ونقص خبرة في الحوكمة، فالحكومة المؤقتة أوقفت اليانصيب، المؤسّسة الرابحة دائماً، أي استغنت عن “ضرائب الفقراء”، سلوكيات تهدّد الاستثمار أغضبت أيمن الأصفري نفسه، ناهيك بقرارات مالية وإدارة شركات ونقلها وإعادة تمليكها لشخصيّات مجهولة، والأشد مفارقةً، الاعتماد على ناقلات النفط الروسية والنفط المعاقَب، وفي الوقت ذاته المطالبة برفع العقوبات، التي رُفعَت أخيراً، لكن هل هذا يعني وقف النفط الروسي؟
يبدو أن خلل المعنى الذي ورثناه من الأسد ما زال حاضراً، نتكاذب بحجّة البراغماتية التي تُلحَق بوصف “أبو محمد”، ونبدّل الأوجه، وربما هذا سحر البراغماتية الشائن، السحر الذي انطلى على سوريين كُثر، إلى حدّ الاقتناع أن اللقاءات في المنازل والمقاهي في دمشق هي السياسة!
درج
————————————
المجلس التشريعي الغائب/ عبسي سميسم
18 مايو 2025
لا تزال الحكومة السورية تدير شؤون البلاد وفق قوانين النظام السابق، ووفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري من تعديلات، دون أن تتمكن هذه السلطة من التعاطي مع القضايا التي تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، بسبب عدم وجود سلطة تشريعية تصادق أو تسنّ قوانين تتماشى مع الواقع الجديد. هذا الأمر أدّى إلى إصدار العديد من القرارات المخالفة للدستور السابق، ولا تستند إلى شرعية قانونية مستمدة من سلطة تشريعية، كما أدّى عدم وجود سلطة تشريعية إلى تعطيل جزئي لعمل السلطة القضائية، التي لا تزال تقف عاجزة عن حلّ الكثير من القضايا التي تتطلب قانوناً يستند إلى مرجعية تشريعية.
كما لا يزال هذا الفراغ التشريعي يشكّل إرباكاً لمعظم مفاصل السلطة التنفيذية بسبب عدم وجود سند قانوني للكثير من القرارات التي ستتخذها، علماً أن الرئيس أحمد الشرع، ومنذ تعيينه رئيساً لسورية من قبل غرفة العمليات العسكرية المشتركة ضمن خطاب النصر الذي ألقاه العقيد حسن عبد الغني في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن هذا المجلس لم يجد طريقه إلى النور رغم الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للشرع بطريقة تشكيله، سواء لناحية طريقة اختيار الأعضاء، أو عددهم، أو توزعهم المناطقي.
ولكن رغم كل الملاحظات على هذا المجلس، فإن إقراره يشكل ضرورة أكثر من ملحة في المرحلة الحالية، وخصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، والذي يتطلب من الجانب السوري تغييرات جذرية في القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبالسياسات المالية والسياسات النقدية، والقوانين المرتبطة بحركة التجارة من استيراد وتصدير وحركة النقل بالعبور “ترانزيت” وغيرها من القطاعات التي سترفع عنها العقوبات ويتطلب تفعيلها سن قوانين جديدة تحتاج إلى مصادقة هيئة تشريعية، تسنّ من خلالها تلك القوانين. وبالتالي يجب على الرئيس السوري أن يسارع إلى تشكيل المجلس التشريعي الذي أقرّه منذ نحو أربعة أشهر، وعلى كل القطاعات الاقتصادية في البلاد أن تعمل على تهيئة بنية قانونية تؤسس لواقع جديد في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، بدلاً من الانتظار، ومن ثم أخذ دور المتفاجئ من التطورات التي تحصل.
العربي الجديد
——————————
بعد ميناء طرطوس.. ماذا بقي لروسيا في سوريا؟/ إياد الجعفري
الأحد 2025/05/18
لم يكن موقع “روسيا اليوم” أميناً في العنوان ومقدمة الخبر الذي نشره عن التفاهم الموقّع بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وبين شركة “موانئ دبي” العالمية، بخصوص استثمار ميناء طرطوس. فقد أشار العنوان إلى أن المذكرة الموقّعة تعنى بتطوير “البنية التحتية للمرافئ”، من دون أن يحدد المرفأ المقصود.
ويمكن تفهّم “الغصّة” الروسية، في الإقرار بخسارة ميناء طرطوس التجاري. ففي مطلع آذار المنصرم، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية المستثمرة للميناء، بثقة مطلقة، عبر وكالة “رويترز”، ليؤكد أن عملية إلغاء عقد استثمار شركته للميناء، “مجرد كلام”. في إشارة إلى إعلان مدير جمارك طرطوس التابع لإدارة الرئيس أحمد الشرع، في 22 كانون الثاني الفائت، إلغاء عقد استثمار الشركة الروسية للميناء. بعد ذلك، بأيام قليلة فقط (في 29 كانون الثاني الفائت)، زار وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، دمشق، والتقى بالشرع. وضم الوفد الروسي ممثلين عن شركة “ستروي ترانس غاز”. ووفق تصريحات بوغدانوف حينها، فإن ممثلي الشركة الروسية أكدوا للجانب السوري استعدادهم لمواصلة العمل، مشيرين إلى الصعوبات التي واجهت عملهم سابقاً. وبعدها بأيام جرت أول محادثة هاتفية، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الشرع.
منذ ذلك المنعطف، اتبعت موسكو دبلوماسية هادئة وإيجابية حيال الإدارة السورية الجديدة. وفيما كان ممثلو الدول الأوروبية منغمسين في جدال مطوّل حول المسار الواجب إتباعه حيال السلطة السورية الجديدة، وحجم ما يمكن رفعه من عقوبات، في حين كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال مشغولة في ترتيب ملفات أكثر أولوية بالنسبة لها من الملف السوري، كانت موسكو في ذلك الحين، تقدم البادرة الإيجابية تلو الأخرى، حيال الإدارة الجديدة في دمشق. فالتزمت بالعقد الموقّع بينها وبين حكومة النظام البائد، وزوّدت الحكومة الجديدة بشحنات من العملة السورية المطبوعة لديها، في وقت كانت فيه السوق تعاني من نقص كبير في السيولة من الليرة. ومن ثم، أرسلت موسكو مليون برميل نفط خام إلى الشواطئ السورية. تلاها مليون برميل نفط أخرى. وبات واضحاً أن النفط الروسي سيملأ الفراغ الناجم عن توقف النفط الإيراني الذي بقي لسنوات شريان حياة “سوريا الأسد”. ومن ثم، شحنت موسكو حمولة من القمح إلى ميناء اللاذقية.
كان جلياً أن رهان موسكو هو أن تجذب القيادة السورية الجديدة إليها، فيما كان الغرب يبتزها بالعقوبات، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أيار الجاري. لكن التطورات في هذا الشهر، خيّبت الرهان الروسي تماماً، فقد استُقبل الشرع بحفاوة في باريس، وتلقى وعداً فرنسياً بالدفع نحو رفع العقوبات الأوروبية في شهر حزيران المقبل. ومن ثم جاء اللقاء التاريخي بين الشرع وترامب في الرياض، بعيد إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. لكن لا يعني ذلك، أن العلاقة بين الطرفين، الإدارة الجديدة في دمشق وموسكو، انقلبت بصورة دراماتيكية، في أيار الجاري. فالمراقبة الدقيقة لما كان يحدث على الصعيد الاقتصادي- الاستثماري تحديداً، تكشف أنه فيما كانت موسكو تبادر كانت دمشق تتملص.
ورغم أن إدارة الشرع لم ترد على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “ستروي ترانس غاز” في مطلع آذار الفائت، والتي قال فيها إن شركته لا تزال تدير ميناء طرطوس، إلا أنه في التوقيت نفسه تقريباً، كانت الحكومة السورية تعلن، بلسان مدير عام الشركة العامة للأسمدة، تخليص الشركة من العقد الروسي، بوصفه بارقة أمل جديدة لدعم القطاع الزراعي في سوريا. وكانت “ستروي ترانس غاز” أيضاً، هي المستثمر لهذه الشركة بمعاملها الثلاثة، بموجب عقدٍ مع نظام الأسد عام 2018 ولـ49 عاماً. بعد ذلك بأسابيع، أي خلال شهر نيسان الفائت، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن تصدير شحنة فوسفات عبر ميناء طرطوس، لأول مرة منذ سقوط النظام السابق. ولم يرافق ذلك أي إعلان أو تصريح يتعلق بمصير استثمار “ستروي ترانس غاز” لمناجم الفوسفات بتدمر لـ50 عاماً بموجب عقدٍ وقّعته مع نظام الأسد عام 2018. إلا أن إعلان الإدارة السورية الجديدة عن مزايدة لبيع عشرات آلاف الأطنان من الفوسفات الرطب من مناجم الفوسفات بتدمر، ومن ثم الإعلان عن مناقصات لإنتاج الفوسفات، كان مؤشراً يشي بقوة إلى أن عقد الاحتكار الروسي الشهير لفوسفات الشرقية بتدمر، قد ذهب أدراج الرياح هو الآخر.
آخر الخسارات الروسية المؤكدة، هو ميناء طرطوس، الذي منحه نظام الأسد لـ”ستروي ترانس غاز” عام 2019، لـ49 عاماً. فقد أصبح الميناء استثماراً إماراتياً. وتُعتبر استثمارات “ستروي ترانس غاز” أضخم الاستثمارات الروسية في سوريا. إذ تصعب الإشارة إلى استثمارات أخرى ذات شأن مقارنة بها. لكن، رغم ضخامة هذه الاستثمارات، من حيث القيمة المعلنة للتمويل المتفق عليه فيها -نصف مليار دولار في حالة ميناء طرطوس- إلا أن الشركة الروسية لم تلتزم ببنود تطوير البنية التحتية وحجم الإنتاج في معظم هذه المشاريع. وفي حالة ميناء طرطوس، تذرعت الإدارة السورية الجديدة بصورة واضحة بهذه النقطة، في إعلان فسخها لعقد استثمار الشركة الروسية للميناء، في 22 كانون الثاني الفائت. وينطبق ذلك على الشركة العامة للأسمدة بحمص، بمعاملها الثلاثة، التي لم تلتزم الشركة الروسية ببنود صيانتها وزيادة الإنتاج فيها، حتى أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق السورية بصورة غير مسبوقة. وبهذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد، في كانون الأول 2023 كانت بصدد وقف تزويد “ستروي ترانس غاز” بالغاز الضروري لتشغيل معمل الأسمدة بحمص، على خلفية تفاقم أزمة توافر الأسمدة بالسوق المحلية. وطلب رئيس الوزراء الأسبق، حسين عرنوس، يومها، من وزير الصناعة في حكومته، البحث عن خيارات بديلة، بعد الوصول إلى قناعة بأن العقد مع الشركة الروسية لم يحقق الجدوى الاقتصادية منه. أي أن حكومة النظام السابق كانت تتجه نحو إلغاء العقد، في حينها.
وهكذا، ورغم رسائل “خطب الود” الروسية حيال السلطة الجديدة في دمشق، تجنبت هذه الأخيرة الوقوع في الفخ الذي وقع فيه قبلها نظام الأسد. فروسيا أنقذت بشار الأسد من السقوط عسكرياً، بعيد تدخلها عام 2015، لكنها فشلت في إنقاذه من تداعيات الانهيار الاقتصادي اللاحق لذلك. وكانت تركة استثماراتها مُكلفة على المصلحة الوطنية السورية، وغير مجدية للاقتصاد السوري. ويمكن تذكر تبجح بشار الأسد، مراراً، بعيد العام 2018، بأن كعكة إعمار سوريا ستكون من نصيب الحلفاء (روسيا، إيران، والصين). لكن أياً من هؤلاء الحلفاء لم يسهم في إعمار سوريا، وتركوا كعكتها للخراب، حتى يئست الحاضنة الموالية للنظام منه، وانفضت عنه عشية سقوطه. وهو درس نراهن على أن الحكومة السورية الحالية تدركه جيداً. ومهما كانت أثمان الاتجاه غرباً، سياسياً، فهي ستبقى مجدية أكثر بلغة الاقتصاد، ومفيدة بصورة أكبر لحياة المواطن السوري المرهق.
المدن
————————————-
تشكيل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سورية/ عدنان علي و حسام رستم
18 مايو 2025
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء يوم السبت، مرسومين رئاسيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في سورية. وجاء في مرسوم رئاسي: “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، واستناداً إلى الإعلان الدستوري، وحرصاً على الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية، وإنصاف ذويهم، يعلن عن تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين”.
وحدد المرسوم مهمة الهيئة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سورية، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم دعم قانوني وإنساني لعائلاتهم. وأوضح أن أمام الهيئة 30 يوماً لوضع نظامها الداخلي والانطلاق في عملها. وعين المرسوم محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة، مع منحها استقلالاً إدارياً ومالياً. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من ذوي المفقودين والمختفين قسراً، ومن منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية، للحكم الجديد في سورية، بالاهتمام بهذا الملف، نظراً إلى أنه يمس مئات آلاف العائلات السورية.
كما نص المرسوم الآخر على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وتعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية. وبموجب المرسوم، “يعين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان”. ومنح المرسوم الهيئة الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
محمد رضا جلخي.. أكاديمي سوري يرأس هيئة المفقودين
محمد رضا جلخي أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. وشغل عدة مناصب في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب. وعقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ”الأمانة السورية للتنمية”، التي تحول اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”. وعُين جلخي في 2 مارس/آذار الماضي في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور السوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.
وإلى جانب عضويته في مجلس أمناء “منظمة التنمية السورية”، يتولى جلخي عدة مناصب قيادية في قطاع التعليم العالي والتنمية، مثل أمين جامعة إدلب، وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ورئيس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية منذ 3 فبراير/شباط 2025، وهو باحث مشرف في المركز السوري للدراسات الاستراتيجية.
عبد الباسط عبد اللطيف.. المكلف بهيئة العدالة الانتقالية
أما المكلف بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، فهو من مواليد محافظة دير الزور 1963، وشغل منصب الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري التابع للمعارضة السياسية السورية. كان قد حصل على إجازة بالحقوق من جامعة حلب 1986، وهو نائب سابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية، ورئيس المكتب السياسي لفصيل “جيش أسود الشرقية”، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة 2018.
العربي الجديد
———————————
العملة السورية الجديدة: اقتصاديون يحذرون من حذف الأصفار والتثبيت/ دانيا الدوس
18 مايو 2025
أثار تصريح وزير المالية السوري محمد يسر برنية حول العمل على إعادة تقييم العملة السورية الحالية، وكشفه عن عملية إصدار عملة سورية جديدة قريبًا، الكثير من التساؤلات والآراء الاقتصادية المتحفظة على هذا المقترح، خوفاً من أن يسبب هذا الإجراء هزات اقتصادية واجتماعية سلبية. وبعض المحللين دعوا إلى حذف الأصفار من العملة وإعادة طباعة عملة جديدة (نيوليرة)، وضخ عملة محلية بلاستيكية، إلا أن هذه الآراء لاقت انتقادات عديدة على اعتبارها مجرد اقتراحات غير مجدية في الفترة الحالية، تُنهك الاقتصاد، خاصة بعد أن كشف مصدر في مصرف سورية المركزي عن تكلفة طباعة القطعة النقدية بنحو 20 سنتيم، ما يعني أن تكلفتها تتجاوز قيمة العملة نفسها.
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش رأى عدم وجود أي مبرر موضوعي لإلغاء أصفار من العملة الحالية، كما أنه من غير المجدي طباعة عملة جديدة في الظروف الراهنة، فالتغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفًا للسياسة النقدية حاليًا. وأشار عياش في تصريحه لـ”لعربي الجديد” إلى أنه يجب ملاحظة التعقيدات وآثار حذف الأصفار، إذ إن ذلك يتطلب تغيير العملة وطباعة عملة جديدة، ما يفرض تكاليف كبيرة ويسبب تعقيدات كثيرة قد تؤدي إلى اضطرابات مالية البلاد بغنى عنها في المرحلة الحالية، لا سيما أن هكذا إجراء في الظروف الراهنة لن يساعد على تحسين قيمة الليرة.
وأضاف: “ما يؤكد تحليلي التصريحات المنقولة عن مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي، والتي تشير إلى إمكانية تغيير شكل العملة وليس قيمتها، وكذلك الإشارة إلى كلفة طباعة العملة الجديدة الباهظة، والتي تفوق قيمة العملة ذاتها، وبالتالي هي عملية غير مجدية اقتصادياً في الوقت الراهن”. وأوضح عياش أنه من حيث المبدأ يتم اللجوء إلى العديد من الأساليب والتقنيات في السياسة النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لا سيما مشكلة التضخم، والذي يُعبر عنه بارتفاع مستمر في الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للدخل وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فمن أحد مظاهره السلبية هي الحاجة لكميات أكبر من النقود للحصول على نفس السلعة.
فقد وصلت معدلات التضخم في بعض البلدان إلى مستوى قياسي لدرجة فقدان العملة المحلية لكامل قوتها الشرائية، وبالتالي تخلي المواطنين عنها، كما في فنزويلا، وكذلك في ألمانيا أواخر الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الدول يستلزم نقل العملة بالعربات لشراء سلع استهلاكية يومية بسيطة، كما في زيمبابوي مثلًا. وقد واجهت بعض الدول هذا المظهر للتضخم من خلال إعادة طباعة عملتها مع تغيير في قيمتها الاسمية من خلال حذف عدة أصفار من قيمتها.
قصة حذف الأصفار من العملة السورية
وشرح عياش أنه تلجأ الدول إلى حذف الأصفار عندما تعاني التضخم المفرط، إذ تفقد العملة قيمتها بسرعة، ويصبح من الصعب التعامل مع الأرقام الكبيرة، إضافة إلى انخفاض الثقة بالعملة بسبب الأزمات الاقتصادية أو السياسات النقدية السيئة، وتبسيط العمليات المالية، فتصبح التعاملات اليومية، والمحاسبة، وإعداد التقارير المالية أكثر سهولة. وأشار إلى أنه يجب التأكيد أن هذا الإجراء يكون شكليًا وقاصرًا ما لم يترافق مع عمليات إصلاح بنيوية في الاقتصاد الوطني تساعد على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتنمية السوق المحلي بما يساعد في تحسين توازنات ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأسعار الصرف، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة القدرة الشرائية للدخل ونمو الطلب بالتزامن مع نمو العرض السلعي والخدمي المتاح، وسيكون إجراء كهذا بمثابة عملية تجميلية تساعد في تخفيف أحد مظاهر التضخم وتسهيل التداول فقط.
ورأى أن من شروط نجاح حذف الأصفار أن يكون الاقتصاد قد تعافى فعلًا وليس مجرد تغيير شكلي، إضافة إلى السيطرة على التضخم حتى لا تفقد العملة قيمتها مجددًا، كما يجب اعتماد سياسات اقتصادية داعمة مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، فضلاً عن وجود إدارة ناجحة لتغيير العملة لمنع التلاعب بالأسعار وخلق حالة من الفوضى المالية. وبالتطبيق على واقع سورية الحالي الذي يعاني من معدلات التضخم المرتفعة، رأى عياش أنه يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى، منها معالجة حالة الركود الاقتصادي أكثر من معالجة مظاهر التضخم، لأن معالجة الركود كفيلة بضبط معدلات التضخم. كما يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى للاقتصاد في المرحلة الراهنة، وهي ترسيخ الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، ما يساهم بمعالجة مظاهر التضخم المتعلقة بالتداول النقدي.
تحديات تثبيت الليرة
وفي ما يتعلق بالطروحات المتعلقة بإصدار عملة بلاستيكية، أكد عياش أن هذا الطرح سابق لأوانه، فهو يتعلق بشكل العملة وموادها وطباعتها، وليس بقيمتها أو دورها، ولذلك هي لا تُساهم في معالجة المشكلات النقدية الناتجة عن التضخم، فهي جانب فني تقني يمكن مناقشته عندما يتخذ المركزي قرار طباعة عملة سورية جديدة. إذ إن العملة البلاستيكية تتمتع بالعديد من المزايا التي تتفوق بها على العملات الموجودة حاليًا، فالقوة والمرونة والمتانة والسماكة والأمان والمقاومة والبيئة والاستدامة والعمر الافتراضي وحتى الكلفة، فهي تُصنع من البوليمرات وليس من القطن أو الكتان.
ولكنها ما زالت محدودة الانتشار، إذ تشكل قرابة 3% فقط من حجم التداول العالمي، وأول من استعملها هي أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، وحاليًا تستخدمها قرابة 45 دولة، وعربيًا نجد السعودية ومصر مؤخرًا. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ”العربي الجديد” أنه من غير الممكن طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة افتتاحية ثابتة معادلة لها بالدولار، وذلك بسبب أن التثبيت القسري للقوة الشرائية لليرة السورية من خلال ربطها بمعادل ثابت بالدولار يعني التزام المصرف المركزي دائمًا باستبدال النيو ليرة بقيمة ثابتة بالدولار، وهذا غير ممكن لأنه يحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولار.
كما أن تداول النيو ليرة بقوتها الشرائية الحقيقية مهما كانت، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين السوق الحرة التي يحكمها التوازن بين القوى المؤثرة بالسوق، وهي العرض والطلب على الدولار، بالإضافة لحجم الإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو تداول أفضل بكثير من تداول النيو ليرة بقيمة وهمية مرتفعة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي ولا تعكس حقيقة القوة الشرائية للنيو ليرة. ورأى خزام أن تثبيت القوة الشرائية المرتفعة للنيو ليرة يعني زيادة تكاليف الإنتاج الوطني عند تقييم التكلفة بالدولار، وبالتالي تصبح المستوردات منافسة للمنتج الوطني، وتصبح الصادرات غير منافسة بالسعر في الأسواق الخارجية، كما أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين.
العربي الجديد
—————————–
حذف الأصفار من العملة…. إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟
إيران تعيد إحياء التومان… والعراق وسوريا ولبنان بين الطباعة والتقويم
بيروت: هدى علاء الدين
17 مايو 2025 م
يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة».
فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.
ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟
ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟
تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً.
وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة.
ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي.
إيران: التومان الجديد… هل يمحو سنوات التضخم؟
في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال.
ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية.
ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي.
هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟
بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية.
وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
سوريا… ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك
أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.
وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية.
لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق.
لبنان… من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد
في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة.
دروس من التجارب الدولية
تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق.
أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي.
وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية.
تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة.
بداية جديدة أم تجميل للواقع؟
تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج.
الشرق الأوسط
———————————–
ماذا يعني أننا نبني للمستقبل؟/ مصطفى سيد عيسى
2025.05.18
قبل أكثر من عشر سنوات كنت في زيارة للعاصمة البريطانية لندن للتعرّف على البرامج الوقائية التي تتّبعها المملكة المتّحدة للتعامل مع الكوارث والتحديات البيئية المستقبلية هناك. زُرت حاجز نهر التايمز الذي شُيّد قبل أكثر من أربعين عاماً لحماية المدينة من الفيضانات النّاتجة عن المدّ والعواصف البحرية. أخبرنا المسؤولون هناك أن هذا الحاجز سيبقى فعّالاً حتى عام 2070 وأنّهم يُطوّرون حلولاً وإجراءاتٍ جديدة لضمان الحماية والحياة حتى عام 2100.
الأحداث المتسارعة حولنا تجعلنا نعيش حياتنا اليومية في تجاذب كبير, يُنسينا أحياناً أنّ هناك من يُخطّط لديمومة الحياة في مكانٍ ما, وأنّ غياب الفلسفة التخطيطية طويلة الأمد قد يُهدّد الحياة فيها بشكلٍ مباشر. في إحدى المشاريع التي شاركت فيها في العاصمة السويدية ستوكهولم، طُلب منا تصميم تدابير وقائية لحماية ركائز أهم الجسور الممتدة فوق المياه من خطر اصطدام السفن بها. كان المسؤولون في محافظة ستوكهولم وما حولها يعلمون يقيناً أن اصطدامًا واحدًا قد يتسبّب بكارثة كبيرة، لا تقتصر على تعطيل حركة السير فوق الجسر المعني فقط، بل على تعطيل الشريان الرئيسي للحياة في العاصمة السويدية. لذلك، تم إنشاء هياكل خرسانية ضخمة تحيط بأساسات الجسر داخل الماء، لتكون حائط صدّ لأي سفينة قد تنحرف عن مسارها.
نحن هنا – في الحديث عن حاجز نهر التايمز أو الهياكل الخرسانية الضخمة حول أساسات الجسور الحساسة في ستوكهولم – لا نتكلم عن تفصيل هندسي فحسب، بل عن فكرة بسيطة وجوهرية مفادها أن المدن الحديثة لا تُبنى ليكون مظهرها جميلاً فقط، بل تُبنى لتقاوم ولتحمي نفسها وسكّانها، ولتصمد أمام الكوارث المتوقعة وغير المتوقعة.
ولو تركنا أوروبا لنوجّه الأنظار لسوريا لرأينا أن بلدنا الحبيب قد عرف الزلازل، والفيضانات، والحروب، والانهيارات الاقتصادية، وأنّه لذلك لا يملك رفاهية التجريب أو التسرّع. بل يحتاج إلى أن يُبنى بعقلية استباقية، تدرس الحاضر والمستقبل وتستعد له دون خوف أو تردد. وهنا أقف على ما دار بيننا وبين معالي وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح حين زرناه كوفدٍ من المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في مكتبه في دمشق وتحدّثنا عن جاهزية المدن السورية للتعامل مع الكوارث المختلفة. كان لديه وضوح في الرؤيا مُلفتة، فهو يفهم أن سوريا ليست بلدًا متجانسًا من حيث الطبيعة أو المناخ. فبين المرتفعات الزلزالية في الشمال الغربي، والأنهار التي تخترق السهول، والمناطق الجافة المعرّضة للتصحر، تقف المدن السورية على مفترق من المخاطر الطبيعية المختلفة. ولا يجب على الوزارة أن تتعامل مع هذه الحالات المختلفة بآلية واحدة. بل إن على سياسات الصمود الحضري أن تُبنى على فهم دقيق لجغرافيا كل منطقة ومخاطرها الخاصة، وهذا ما أكّد لنا السيد رائد الصالح أنّ الوزارة تدرسه الآن.
الصمود الحضري – التطبيق العملي لمعنى الاستدامة
الصمود الحضري أو Urban Resilience كما يُعرف باللغة الإنجليزية هو التطبيق العملي لمفهوم الإستدامة. أعتقد أنّك سمعت مراراً بمصطلح الاستدامة لكنّك نادراً ما تسمع عن آلية واقعية للوصول إليها. يتمحور مفهوم الصمود الحضري حول سؤال جوهري عن قدرة المدينة على حماية أهلها من الظروف الصعبة بحيث تكون الحياة مستدامة فيها بشكل طبيعي ولأطول مدة زمنية ممكنة.
في السياق السوري، يكتسب هذا المفهوم بعدًا استثنائيًا. فنحن لسنا فقط أمام دولة خرجت من حالة حرب مدمّرة، بل أمام واقع معقّد تشوبه تحديات جيولوجية، ومناخية، واقتصادية، واجتماعية. فكيف نخطط وأمامنا مُدنٌ متعبة تعرف أن احتمالية وقوع الزلازل ليس مجرّد فرضية نظرية بل واقع حقيقي في شمال غرب سوريا مثلاً؟ بالإضافة إلى وجود مساكن بسيطة للنّازحين قد تنهار على رؤوسهم بسهولة؟ هل نعيد البناء بنفس العقلية والشكل والموقع والمواد؟ أم نعيد النّظر في ذلك كلّه لنحمي ساكنيها من كارثة محتملة؟
ثم هناك خطر الفيضانات الذي يهدّد مناطق عدّة من سوريا، خصوصًا تلك المجاورة للأنهار والسدود كبعض المناطق في ريف حماة وحوض العاصي وصولاً إلى تخوم دير الزور. فالمدن هناك تحتاج إلى تخطيط يراعي ألا تكون البيوت في مجاري السيول وألا تكون المستشفيات في مناطق تنعدم فيها طرق الإخلاء. ففي عام 2023، تسبّبت الأمطار الغزيرة في شلل جزئي لعدة مناطق في ريف طرطوس، بعدما غمرت المياه الطرق وأعاقت الوصول إلى المشافي والمدارس. لم تكن المشكلة في كمية الأمطار فقط، بل في غياب البنية التصريفية المناسبة، والتوسع العشوائي الذي تجاهل طبوغرافيا الأرض.
التغير المناخي بات عنصرًا جديدًا في معادلة التخطيط الحضري. فازدياد درجات الحرارة، وتغيّر أنماط الأمطار، وامتداد فصول الجفاف كلها ظواهر باتت تؤثر بشكل مباشر على المدن السورية، من الحسكة إلى درعا. لذا، لم يعد مقبولًا أن تستمر خطط الإعمار بنفس الأسس التقليدية. بل نحتاج إلى هندسة حضرية تراعي مرونة الأنظمة البيئية، وتُقلّل من آثار الاحتباس الحراري، وتُعيد النظر في العلاقة بين المدينة والطبيعة.
أمّا إذا انتقلنا إلى المنطقة الشرقية، حيث الحقول النفطية، نجد نوعًا آخر من الأخطار، كالحرائق. فالمناطق الغنية بالبترول تحتاج إلى إجراءات خاصة للسلامة، من بنية تحتية مقاومة للحرائق، إلى توزيع عمراني يراعي المسافات الآمنة بين النشاطات السكنية والصناعية وخطوط الإمداد اللوجستية.
ولكن الصمود الحقيقي لا يقتصر على الكوارث الطبيعية. فهناك الصمود الاقتصادي وهو ما ناقشناه في المقال السابق حيث تكلّمنا على أنّ المدينة كائنٌ اقتصاديٌ حيّ. وأنّ المدينة التي تُبنى بلا شبكة مواصلات، أو بلا سوق عمل مستقر، ستنهار تدريجيًّا تحت ضغط البطالة، والهجرة، والركود. لهذا فإن التخطيط الحضري القادر على الصمود يشمل تفاصيل كثيرة: من المواد المستخدمة في البناء، إلى موقع المدارس، مرورًا بتوزيع الأسواق ومحطات الوقود ومراكز الاستجابة السريعة. الصمود الاقتصادي لا يكون فقط عبر تنويع الوظائف أو دعم المشروعات الصغيرة، بل أيضاً من خلال تحقيق العدالة في توزيع البنية التحتية. فلا يمكن لمدينة أن تنمو إذا بقيت محرومة من الطرق الحديثة أو شبكات الكهرباء المستقرة أو الإنترنت السريع. المدينة التي تُحرم من الأساسيات تُترك وحيدة أمام موجات النزوح الاقتصادي، وهذا بحد ذاته يُفقدها القدرة على الصمود.
لا يمكن بناء مدنٍ صامدة من دون تحقيق العدالة المكانية. ما نعنيه بالعدالة المكانية هو ضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع السكان دون تمييز جغرافي أو اجتماعي. فلا يجوز أن تبقى بعض الأحياء خارج تغطية شبكات الماء أو النقل أو الإنترنت، فقط لأنها “بعيدة” أو “غير مربحة اقتصاديًا”. المدينة الصامدة هي التي تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات، وتُزيل الفجوة بين المدينة والرّيف، وهي فجوة كبيرة إذا نظرنا بصدق إلى الحالة السورية.
كيف نبني مدنًا أكثر صمودًا واستدامة؟
إن مسألة الصمود الحضري أعمق بكثير من مجرّد استخدام تقنيات مقاومة للزلازل عند بناء الأبراج الجديدة في سوريا. نريد من هذا المقال وما سبقه من مقالات أن نرفع من مستوى الوعي والإلمام بعدد من المفاهيم المفصلية في عملية إعادة الإعمار. وكذلك أن نشارك في إعادة تشكيل العقلية التخطيطية بحيث تُبنى المدن بفهمٍ واقعي للمخاطر، وبطموحٍ اقتصادي واجتماعي لا يرضى بتكرار أخطاء الماضي.
أول ما نحتاجه هو ما أشار إليه معالي وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح في لقائنا معه، حيث ذكر مسائل في غاية الأهمية حول دراسة أفضل الممارسات العالمية لإدارة الطوارئ والكوارث وبناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، توثّق المخاطر الجيولوجية والمناخية في كل منطقة حسب نوعية المخاطر المرتبطة بها، وأن يتم الدمج بين المعطيات الحديثة والدروس المتراكمة من العقود الماضية. هذه البيانات والمعلومات ستكون بدورها مرشدةً لرسم خرائط جديدة توضّح مثلاً المناطق التي يكون فيها البناء محظوراً أو مقيّداً، بينما تشير إلى الأماكن الأكثر أمناً وسلامة للسكان.
ثانيًا، علينا مراجعة معايير البناء وشروط تدريب الكوادر المحلية وفاعلية أنظمة الإشراف على مشاريع البناء. فالبناء السريع لا يعني أنّه الأفضل، ولا الرخيص يعني أنّه الأذكى. جودة البناء وكفاءته تكمن في كونه قادرًا على الصمود لعقود، دون أن يتحوّل إلى عبء على الدولة أو خطر على السكان.
ثالثًا، لا بد من الدمج بين أهداف الصمود وأهداف الاستدامة. يجب على المدن أن تعيش طويلًا، ولكن يجب أيضًا أن تُحافظ على البيئة، وأن تُعيد تدوير مواردها، وتُقلّل من اعتمادها على الطاقة المستوردة. وهذا يتطلب شبكات نقل عام فعّالة، ونظم إدارة مياه متطوّرة، ومحفّزات تُشجّع على العمارة البيئية في كل مشاريع البناء الجديدة.
أخيرًا، لا يُمكن أن نحقق كل هذا دون مشاركة الناس. فالصمود الحضري لا تصنعه القرارات الحكومية وحدها، بل يصنعه وعي الناس بحقوقهم وواجباتهم، ومشاركتهم في صيانة المدينة والتمسّك بجودتها، والتبليغ عن مكامن الخطر فيها.
تأكيداً على ما ذكرته في مقالات سابقة فإننا اليوم نعيش لحظة تاريخية ونملك فرصة نادرة لتجاوز مرحلة” الترقيع” العمراني إلى مرحلة تخطيطٍ واعٍ. ولهذا، يجب أن يُوضع إطار وطني لإعادة تخطيط المدن السورية انطلاقاً من أسس التخطيط الحضري الحديثة التي تراعي التوازن الاقتصادي ومبادئ الاستدامة والصمود الحضري. وهذا ما سأختم به هذه السلسلة من المقالات حول إعادة إعمار سوريا.
تلفزيون سوريا
———————–
عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي من خلال “سويفت”.. متطلبات تقنية وتحديات تنفيذية/ أحمد الكناني
18 مايو 2025
استهدفت العقوبات الأميركية والأوروبية، المفروضة على سوريا، القطاع المصرفي بشكل رئيسي، مصرف سوريا المركزي والكيانات المالية المرتبط به كالمصرف التجاري السوري، لما كان لهذا القطاع من دور كبير في إنعاش النظام السابق بتحركاته النقدية والتجارية. واليوم يأتي قرار رفع العقوبات، الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليقدم فرصة للكيانات المالية السورية في أن تساهم بإعادة الانتعاش الاقتصادي، وصياغة تموضع جديد لسوريا في الاقتصاد العالمي.
وتركز التصريحات الحكومية وتحليلات الخبراء الاقتصاديين على تفعيل “سويفت”، وهو النظام المصرفي الدولي للتحويلات المالية، الذي يلعب دورًا كبيرًا من ناحية تدفق أموال المغتربين والمستثمرين، والتبادلات المالية الدولية. لكن ما هو نظام “سويفت”، وكيف سيكون أثره على عمل المصارف السورية بعد رفع العقوبات الأميركية؟
“سويفت” والمصرف المركزي
يشرح الخبير والمستشار المصرفي عامر شهدا نظام “سويفت” على أنه “منظمة مالية تختص بالتحويلات المالية، وخلق شبكة ربط بين المصارف المحلية والمصارف العالمية، وهي خاضعة لدرجة عالية من السرية لأنها تستخدم نظام التشفير المالي. وعليه، فهي تيسر التحويل المالي بين سوريا والدول، وتسهل عمليات الاستيراد والتصدير بعمولة منخفضة، ويتم تحويل قيم الصادرات والاستيراد لسوريا عبر سويفت بسرعة عالية”، لافتًا إلى أن دخول رؤوس الأموال الأجنبية واستثماراتها يتم من خلال “سويفت”، فضلًا عن إعادة اشتراك سوريا بالبورصة والأسواق المالية العالمية.
ويضيف الخبير شهدا في حديثه لـ”الترا سوريا” أن رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي سيجعله من البنوك المعتمدة عند صندوق النقد الدولي، بعد تحقيق الشروط المتعلقة بالشفافية في عرض البيانات الخاصة بالمصرف، إضافة إلى أن رفع العقوبات يتيح لـ”المركزي” تمويل المؤسسات الحكومية، ودفع استيراداتها من احتياجات تكنولوجية ومواد أولية، وخلق مراسلين خارج سوريا، وعقد الاتفاقيات النقدية.
انعكاسات مصرفية
يعتقد الباحث الاقتصادي عبد العظيم مغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية الأخرى سيمكنها، عبر “سويفت”، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
فيما يركز المستشار المصرفي شهدا على المصرف التجاري السوري كأضخم وأهم المصارف، والذي كان يملك في السابق 154 مراسلًا في العالم، ويختص في العمليات التجارية الكبرى بقطاعات الطاقة والسدود والمطارات والبنى التحتية، وعليه يشكل رفع العقوبات عنه تفعيلًا حقيقيًا لدوره السابق، في ظل عودة الاستثمارات الخارجية إلى سوريا.
وحول المصارف الخاصة ينوه شهدا إلى وجود أقنية مسبقة تستخدمها البنوك الخاصة عبر نظام “سويفت” بشكل محدود تربطها مع المصارف الأم التابعة لها، خاصة في الخليج ولبنان، وبالتالي فرفع العقوبات يعطي لعملها قدرًا أكبر من الحرية، إضافة إلى إمكانية تقديم الدعم لـ “المركزي” تقنيًا ريثما يتم ربطه بالنظام، وذلك وفق تقديرات زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة.
تحديات تقنية
يرى الباحث الاقتصادي مغربل، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن إعادة تفعيل “سويفت” يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية. كما يستوجب تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.
فيما ينوه الخبير شهدا إلى التحديات التقنية المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية، لا سيما أن 14 عامًا مرت على المصرف المركزي ولم يتم فيها إجراء أي عمليات مرتبطة بالمعاملات الخارجية، سواء من حيث الاستيراد، التصدير، فتح اعتمادات، كفالات أجنبية، وتتميز هذه الأعمال بمستوى عال من الحساسية، كونها تتعامل مع مصارف خارجية ذات مستوى احترافي في العمل، لافتًا إلى أن عدم الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية سيؤدي إلى التلكؤ في العمل المصرفي، ولذلك انعكاسات سلبية في موضوع الثقة، وإعطاء التمويلات، ونظرة المصارف الخارجية للمصارف السورية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، بدء المصرف العمل على تفعيل نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات الدولية، وأن بنوكًا عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا، لافتًا إلى تواصل الحكومة السورية والمصرف المركزي مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار قبل رفع العقوبات.
الترا سوريا
—————————
دمشق مرة ثانية/ بشير البكر
الإثنين 2025/05/19
زرت دمشق في شباط الماضي بعد غياب 45 عاماً. وحينما غادرتها بعد حوالي أسبوعين، قلت بيني وبين نفسي، إن هذه الزيارة غير محسوبة. لم يكن الوقت كافياً لرؤية الأهل والأصدقاء والزملاء، والقيام بجولات في المدينة من أجل الكتابة. أغلب الذين التقيت بهم عتبوا عليّ لأني غادرت ولم أمكث مدة أطول. وكان لديهم الحق في ذلك. كان يجب أن أكرس وقتاً أطول لتلك الزيارة، وألا تقتصر على دمشق لوحدها. ثمة من دعاني لزيارة السويداء ودرعا وحلب وحمص وحماة واللاذقية، وخاطبني كثيرون من أفراد عائلتي وأقربائي، وألحوا على ضرورة زيارة مدينتي الحسكة، التي تعيش وضعاً صعباً يفوق ما تواجهه المدن السورية الأخرى.
لم يكن لدي من الوقت أكثر من أسبوعين، وكان عليّ أن أرجع إلى باريس بسبب ارتباطي بمواعيد تحددت قبل سقوط النظام، وما كان في مقدوري تأجيلها. ثم أن زيارة دمشق في ذلك الوقت كانت على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلي، لأني اردت التعرف من كثب على الإدارة الجديدة، التي تربطني صداقات ببعض سياسييها وإعلاميها. حاولت أن أجد أجوبة للكثير من الأسئلة التي بقيت تشغلني مثل غالبية السوريين، الذين يأملون أن تستقر سوريا، وتباشر ورشة عمل لتنظيف البلد، ووضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية على أسس تشاركية، وتحقيق العدالة للمتضررين من عهد آل الأسد، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها نظاما الأسد الأب والابن.
زيارة المدن السورية الأخرى أمر لا يقلّ إلحاحاً عن دمشق، التي تشكل نقطة البداية في الوطن سياسياً ووجدانياً. فإذا لم تكن دمشق مستقرة وعلى عافية، لن يستقيم الوضع في بقية أنحاء البلد. وهذا أمر شهدناه طيلة أعوام الثورة، حينما تمكن النظام العام 2015 من استعادة المبادرة بمساعدة روسيا. وبعدما كان على وشك السقوط، قام على قدميه سياسياً وعسكرياً. ولعبت روسيا وإيران ورقة السيطرة على العاصمة من أجل تثبيت بشار الأسد، وإعادة تأهيله محلياً وعربياً ودولياً.
زيارة مدينة الحسكة، لا تقارن بأي زيارة أخرى، كونها المدينة حيث وُلدت، وعشت فيها طفولتي وشبابي الأول، وما زال القسم الأكبر من عائلتي يقيم فيها، وفوق ذلك لها خصوصية سياسية مهمة، لأنها ليست محكومة من الدولة السورية، بل من “قوات سوريا الديموقراطية” التابعة للإدارة الذاتية الكردية، والتي تفرض على أي زائر إلى هناك إجراءات، لا أقبلها من طرفي، لأنها تمس مبدأ سورية هذه المنطقة، وتطعن في أنها جزء من الدولة السورية. وينتظر أهل المدينة من أبنائها المثقفين والإعلاميين والسياسيين أن يعرضوا قضيتها أمام الرأي العام السوري، عسى أن تبادر السلطات لإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعانيها، لا سيما المياه، عصب الحياة للاستهلاك والزراعة التي تأثرت بسبب تراجع المطر. وتعد حصيلة هذه السنة كارثية، إلى حد أنه يتوجب إعلانها منطقة منكوبة.
لا أحس بأن زيارتي الثانية التي بدأت قبل أيام ستحقق كل ما أصبو إليه، والقسط الأكبر منه عاطفي ووجداني، وأظن أن ذلك لن يتحقق كلياً، حتى لو أقمت هنا بصورة نهائية، وهذا سيحدث حتماً ذات يوم. ذلك أن غياب 45 عاماً ليس بالأمر العادي الذي يمكن للمرء أن يمر عليه بسهولة. أحتاج إلى وقت كي أعوض ما فاتني هنا، وإلى جهد كبير حتى أسدد لبلدي ما له في ذمتي من ديون، والقيام بما يترتب عليّ من مسؤوليات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من جميع السوريين التكاتف من أجل النهوض بسوريا التي نحبها، ونطمح لأن ترجع أرض لقاء وثقافة وقلب المشرق العربي وحاضنة قضاياه، خصوصاً قضية فلسطين.
أحس اليوم بفاصل زمني كبير مر بين الزيارتين، رغم أن الوقت لم يتجاوز الشهرين ونصف الشهر. ربما يرجع السبب إلى أن كثير من التطورات، الأمر الذي يبعث على الإحساس بأن المدة التي استغرقتها طويلة، أو ربما هو مجرد إحساس تشكل لدي لكثرة ما استغرقت من تفكير في كل تفصيل سوري، وهذا شأن لا يقتصر على فئة دون غيرها من السوريين، بل تتشاركه الغالبية العظمى، خصوصاً أبناء البلد الذين غادروا بعد العام 2011، ولم تتسنّ لهم زيارته بعد سقوط النظام، وذلك لأسباب تتعلق بقوانين اللجوء، التي تسمح للاجئ بزيارة كل العالم، باستثناء البلد الذي جاء منه.
دمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، تختلف كلياً. ذلك ما تقوله عيون السوريين التي تبرق بالأمل في أن تبدأ البلاد مرحلة التعافي، وتباشر ردم المسافات بين أبنائها ومكوناتها، لترجع سوريا إلى لونها الزاهي المتعدد والمتنوع.
المدن
——————————-
الوطنية السورية بين موالين وخونة!/ سميرة المسالمة
الإثنين 2025/05/19
يصر جمهور المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي على تصنيف الكتابات بين معارضة وموالاة للسلطات الحاكمة، في استثمار متعمد للخلط الحاصل في تعريف الوطنية السورية تحديداً، وتجريدها من معاني الانتماء الصادق والمسؤول إلى الوطن، بما يعنيه من أرض وشعب وتاريخ ومستقبل، بغض النظر عن الولاءات للسلطات الحاكمة، كتسليم كامل بأنها بعيدة عن أي نقد أو منزهة عن الخطأ، أو على الجانب الآخر باعتبارها عدواً مسبق الصنع للمواطنين، أياً كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم.
في الاتجاهات السورية المختلفة، من الموالين الجدد، أو المعارضين التقليديين، والمستجدين من منشقين سابقين عن النظام، ومدّعي براءتهم منه، ربما لا يوجد توصيف إضافي؛ نحن أمام تعنت مسبق للرأي، فبينما يقبل كل هؤلاء تباين آرائهم حول قضايا مختلفة مع مرور الزمن، يرفضون خطابات السلطة الحالية المنقلبة على نفسها، كأن التغيير الفكري والوعي المجتمعي والسياسي مرهون بالعامة دون السلطة.
من هذا المنطق الغريب، تعد أي سردية عن الواقع الجديد قابلة للدحض، ومغلفة بخلفية طائفية، أو موقف سياسي، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فلكل منها جمهوره وسلاحه المضاد للآخر، على الرغم من أن الاصطفاف السياسي ضد أو مع السلطة لا يزال سابقاً لأوانه، في المحاكمة المنطقية لبداية جديدة انطلاقاً من يوم التحرير في الثامن من كانون أول/ ديسمبر 2024، إذا كان الأمر لا يتعلق برفض الحركات الجهادية الإسلامية ومن يواليها بالمطلق.
وحيث لا تزال رواسب النظام السابق على كل منا حاضرة في تقييماتنا الموالية أو المختلفة، ما يجعل كل منا اليوم أحد وسائل التأجيج الطائفي سواء عمد إلى ذلك أو لم يفعل، وفق مبدأ معي أو ضدي، هذا المبدأ الذي صار يمارسه صناع الرأي “المؤثرين الجدد” ويوافق عليه جمهورهم العريض المتحالف ضد الآخر.
في ظل هذا المشهد، ومع الإقرار بوجود “جيوش الكترونية” هدفها تعميق أزمة الهويات المحلية وتغذية الانقسامات القومية، واختزال مفهوم الوطنية في الولاء المطلق للحاكم سواء أصاب أم أخطأ، واعتبار أي نقد أو تعبير حر عن الرأي “خيانة وطنية” في دمج بين السلطة والوطن، فإن مواجهة التحريض الطائفي لا تكون بكم الأفواه وخلق مجتمع “متجانس”، بل عبر فتح باب الحوار وتصويب المفاهيم، وتنظيم المجتمع المحلي بما يسمح بتوسيع معرفته بالمختلف عنه والقبول به.
فشيطنة الآخر لا تبني وطناً قابلاً للحياة، كما أن حراسة الهوية الوطنية لا تكون بتخوين المخالفين في الرأي، إذ أن الوطنية لا تقاس بدرجة القرب أو البعد الفيزيائي أو الأيديولوجي عن السلطة، ولا بحجم الهتافات لها، والولاء الأعمى، كما لا يصح فهم الاعتراض أو التقليل من حجم أي انجاز، أو انكاره، على أنه ثبات على الموقف بالاصطفاف أو التموقع في جهة المعارضة.
ومن البدهي أن الحكومات الناشئة تحتاج إلى دعم شعبي يسبق الاستقطاب السياسي بين مولاة ومعارضة، فتشكيل مؤسسات جامعة على أساس الشرعية السياسية والقانونية لا يأتي بقرار سلطوي منفرد ومباشر، كما أن الدعم لها لا يعني التمجيد أو اعتبار الحكومة فوق مستوى الانزلاق إلى أي خطأ، لذلك، فإن الحاجة إلى التصويب والنقد والاعتراض، وإبداء الرأي ضرورة بنيوية لأي مشروع وطني.
وعندما تتصلب السلطة في رأيها ومواقفها، تصبح المعارضة المنظمة وبرامجها البديلة، من أدوات التقويم المجتمعي الفعالة، فالغاية هي بناء الدولة لا عرقلتها وتعطيل مشاريعها، وبالمقابل ضمان حرية التعبير واحترام الخصوصيات الثقافية للمجتمع المحلي، لا ينبغي أن يتحولا إلى أدوات تمزق الوحدة الوطنية المجتمعية قبل الجغرافية، بل أن يمثل كل ذلك مرتكزاً أساسيا في بناء جسور الثقة التي تعمل اليوم “الحسابات الوهمية” على هدمها وبناء جدران فصل طائفي على أنقاضها.
المدن
——————————
سُلاف فواخرجي في مصر: دعم فنّي أم إعادة تدوير موقف سياسي؟/ إيمان عادل
19.05.2025
سُلاف فواخرجي لم تكن فقط مؤيّدة للأسد، بل كرّست مسيرتها للدفاع عن روايته الرسمية، حتى لحظة انكشاف الجرائم، ولم يكن دعمها مجرّد “رأي سياسي”، بل انخراط رمزي في تبييض نظام دموي، ورغم ذلك، لم يأتِ الدفاع عنها من زملائها السوريين (إلا القليل) بل جاء بحرارة من القاهرة.
مع قرار نقابة الفنانين السوريين الأخير بشطب عضوية الممثّلة سُلاف فواخرجي من سجّلاتها، على خلفية مواقفها السابقة المؤيّدة لنظام بشّار الأسد، تصدّر عدد من الفنّانين المصريين المشهد بتصريحات تضامنية معها، ما فتح باباً واسعاً للتساؤلات، هل هذا الدعم فعلاً، انتصار لحرّية التعبير؟ أم امتداد طبيعي لموقف سياسي- ثقافي قديم، راسخ، ومزمن؟
إنها المرّة الأولى التي يتقاطع فيها موقف فنّانين مصريين مع الأنظمة السلطوية العربية. فالمعروف أن عدداً منهم وقفوا إلى جانب نظام بشّار الأسد منذ بدايات الثورة السورية، مثل إلهام شاهين، ومحمد صبحي، وفاروق الفيشاوي وغيرهم، وزاروا دمشق وشاركوا في مهرجانات رسمية في عزّ الحرب، وأدلوا بتصريحات مؤيّدة لمعركة الأسد ضدّ “المعارضة الإسلامية المسلّحة”.
إلهام شاهين قبل ثماني سنوات، قالت إن “من العقل مناصرة الجيش السوري ضدّ “داعش” الجنسيّات الغريبة عن الشعب السوري والمأجورة، ولو حصلت انتهاكات، فهذا هو منطق الحرب”، واعتبرت بشّار الأسد “حاكماً يحمي بلاده من المرتزقة”.
توقّع البعض أن إلهام شاهين ستتراجع عن موقفها بعد سقوط بشّار الأسد، لكن بسبب أن من أسقطه جماعة إسلامية مسلّحة انشقت عن “القاعدة”، فإنها ما زالت تتمسّك بموقفها، وترفض وصف بشّار الأسد بـ”مجرم حرب”.
محمد صبحي قال أيضاً عقب زيارته سوريا في ٢٠١٧؛ وواجه هجوماً وقتها: “إذا كنتم سوريين رافضين النظام، فالأولى والأشجع لكم أن تذهبوا إلى تغيير النظام، أما إذا كنتم غير سوريين، فعليكم أن تتركوا النظام لأهل البلد، فهم كفيلون به”.
ورغم شائعة تأييد عادل إمام لبشّار الأسد، فإن “الزعيم” كان يقرّر دائماً إمساك العصا من المنتصف، لأنه بحكم ما علّمته التجارب، يرى أن الأنظمة لا رهان عليها، وبالتالي لم يضع تاريخه تحت رحمة موقف قد يُحسَب ضدّه يوماً ما، وكان أكثر دبلوماسية حين قال: “ليس المهم أنني أؤيّد أو أعارض الثورة السورية… المهم، بل الأهمّ أن يتوقّف حمّام الدم الذي يسيل على تراب الأرض السورية”.
دعم فنّي أم إعادة تدوير موقف سياسي؟
دعم طيف من الوسط الفنّي في مصر لسُلاف فواخرجي، بدا في شكله الظاهري وقوفاً في وجه معاقبة الفنّ ومحاصرة حرّية التعبير، لكنه قد يُخفي وراءه عقدة الإسلام السياسي عند الفنّانين المصريين، بدليل أن الفنّانين المصريين، لم يدينوا فصل أكثر من ٢٠٠ فنّان سوري من نقابتهم في عهد بشّار الأسد، ولم يدينوا ولو ببيان، ما تعرّض له فنّانون سوريون آخرون، أمثال: مي سكاف، وسمر كوكش، وزكي كورديللو وغيرهم، ممن لاحقهم نظام الأسد واعتقلهم.
سُلاف فواخرجي لم تكن فقط مؤيّدة للأسد، بل كرّست مسيرتها للدفاع عن روايته الرسمية، حتى لحظة انكشاف الجرائم، ولم يكن دعمها مجرّد “رأي سياسي”، بل انخراط رمزي في تبييض نظام دموي، ورغم ذلك، لم يأتِ الدفاع عنها من زملائها السوريين (إلا القليل) بل جاء بحرارة من القاهرة.
منذ ثورة 2011، عاش الوسط الفنّي المصري تجربة صعود التيّار الإسلامي إلى الحكم، وما تبعه من تهديد مباشر لحرّية التعبير والفنون. فنّانتان مثل إلهام شاهين ووفاء عامر تعرّضتا لحملات تشويه من إعلاميين ذوي توجّهات دينية. الفنّان محمد صبحي نفسه، حُوصر إعلامياً في تلك الفترة بسبب مواقفه الفكرية المستقلّة، لذلك، بدا النظام السوري بالنسبة إليهم “أهون الشرّين”: نظام علماني قمعي، أفضل من دولة دينية محتملة.
كانت إلهام شاهين من أبرز الأصوات الفنّية التي تصدّت لتوجّهات جماعة “الإخوان المسلمين”، فقد أعلنت رفضها لحكمهم منذ البداية، مؤكّدة أن “الجماعة تسعى إلى تغيير هوّية مصر الثقافية والفنّية”.
تعرّضت شاهين لهجوم شرس عبر بعض القنوات الدينية، خاصّة قناة “الحافظ”، التي استهدفتها بشكل مباشر، ورغم ذلك، لم تتراجع عن موقفها، بل قامت برفع دعوى قضائية ضدّ القناة، انتهت بحكم قضائي بإغلاقها، وهو ما اعتبرته انتصاراً للفنّ وحرّية التعبير.
في تصريحاتها، أكّدت شاهين أنها تلقّت تهديدات بالقتل خلال فترة حكم “الإخوان”، لكنّها لم تخشَ هذه التهديدات، واستمرّت في الدفاع عن حرّية الفنّ والفنّانين، كما شاركت في أعمال فنّية تناولت قضايا التطرّف والإرهاب، مثل مسلسل “بطلوع الروح”، إنتاج “شركة الصبّاح” اللبنانية.
الأسد أو الجهاديون؟
تعلم سُلاف فواخرجي أن فنّاني مصر هم الحاضنة الموضوعية لحالتها، وهي الآن في وضع أقرب إلى “التمسّح” بهم، وتظهر بشكل يومي في صور مع رموز فنّية مصرية، وتحضر الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية بشكل منتظم، وتوثّقها على صفحتها.
وجود فواخرجي قرب بعض الفنّانين المصريين ليس قرباً ودّياً فقط، بل محاولة التصاق بانتقائيتهم الأخلاقية، وسرديتهم الراسخة، وهي: “إذا لم يحكم الأسد، فسيحكم الجهاديون”، وهو ما يعتبره بعض الفنّانين المصريين أمراً ممقوتاً ومنفّراً حتى لو ارتضاه الشعب السوري، وذلك بسبب جروحهم التي ما زالت طازج، بسبب حكم الإسلام السياسي لمصر بين العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٣، أما بتضامنهم الصاخب مع فواخرجي، فهم يرسّخون من جديد خطاباً قديماً، يرى في أي تغيير شعبي خطراً وجودياً، وفي “الاستقرار” السلطوي خلاصاً، ولو جاء على حساب إرادة الشعوب.
الحالة الفواخرجية بمعزل عن قمعها
بعد سقوط نظام الأسد بأيّام، كتبت فواخرجي على صفحتها الشخصية على “فايسبوك”: “لن أتنكّر لما كنت عليه سابقاً، ولم أكن خائفة ولن أكون. طلب إلي البعض أن أمسح صوراً لي… ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكّر أنا لها؟ بناء على طلب الأصدقاء من الطرفين، سأمسح بعضها، لكنّ الصور منتشرة وموجودة، ولأن تاريخ أي منّا لا نستطيع محوه متى شئنا، أو طُلب إلينا”، وربما تقصد هنا صورها مع بشّار الأسد، التي فعلاً لم تعد موجودة على صفحتها.
خطوة انسحابية ومبادرة تصالحية سريعة، لكنّها رُفضت شعبياً ونقابياً، وعُوقبت فواخرجي وهُوجمت على كلا الموقفين: المؤيّد لبشّار والمنسحب لاحقاً، وعلى رغم اختلاف الآراء حول فصلها من النقابة، وحول دور هذه المؤسّسة ومهمّتها في الدفاع عن الفنّانيين، فإن الحميّة الثورية غلبت على جوّ النقابة، وأعادت بعض الفنّانين المفصولين، ومنحت عضوية شرفية للمغنّي اللبناني فضل شاكر، وحوّلت النقابة غير المنتخبة إلى ما يشبه مؤسّسة توزيع صكوك وطنية!
في تصريحات سابقة لسُلاف فواخرجي، ذكرت أن سوريا كانت مستقرّة حتى حصلت الاحتجاجات، وأن الشعب كلّه تضرّر اقتصادياً، وهو ما ساءها، رغم أن مقدار ضررها لا يمكن أن يُقارن بمن قُتلوا أو سُجنوا لعقود، أو هُجّروا من بلدهم، ووصفت بشّار الأسد وقتها بصمام الأمان لسوريا.
كانت سُلاف فواخرجي جزءاً من فئة موجودة دائماً عند أي شعب: من يحكم بما يراه أمام عينيه فقط، وفي محيط طبقته، ووضعه وأمانه الشخصي، ولا يطلب سوى نجاته هو، حتى ولو كانت نجاة فردية على حساب مئات الآلاف غيره.
وفي موقفها الواضح والداعم لبشّار الأسد، ظنّت سُلاف فواخرجي أنها في المساحة المضمونة، فنظام الأسد كان من المستحيل أن يسقط، على الأقل قبل السنوات العشرة الأخيرة. كانت تلك الهتافات التي طالبت بسقوطه أشبه بضرب من الجنون، وكان السوريون يعلمون ذلك، ويرون كيف مدّت عائلة الأسد جذورها نحو البقاء الأبدي في الحكم، جيلاً بعد جيل. وربما ظنّت أن ذلك؛ وإن حدث، فستكون قد عاشت حياتها، وربما عاش جيل أو جيلان من عائلتها في حياة مضمونة من دون خسائر.
لم تتطلّع سلاف فواخرجي أبعد من موطئ قدميها. لكن، هل هذه “السذاجة” تُعدّ جريمة يُحاسب عليها القانون أو العدالة؟ سُلاف فواخرجي دخلت بقدميها في مأزق أخلاقي، واعتذرت عنه وبرّرته، لكنّها أصرّت لاحقاً على التمسّك بالتمسّح بـ”السيّد الرئيس”، والحديث عن مناقبه!
يعترض البعض ليس فقط على شطب فواخرجي من نقابة الفنّانين السوريين، بل أيضاً على كونها وجدت حاضنة فنّية مرحّبة في مصر، وكأن الحكم الصادر بحقّها الآن، هو عزلها فنّياً واجتماعياً عن أي شبر في الوطن العربي.
ما حدث مع سُلاف فواخرجي هو أول الخيط للاسترشاد بأن القمع المهني في مرحلة ما بعد الاستبداد، هو اختبار حقيقي لمدى نضج قوى التغيير. العراق مثال صارخ على ما لا ينبغي فعله. وسوريا بعد سقوط النظام، أمام خيارين: العدالة المنصفة، أو إعادة إنتاج الكراهية باسم الانتقام
درج
—————————————
إسرائيل تسرق ذاكرة سوريا!/ مشاري الذايدي
حتى يقتنع بعض اللامبالين بأهمّية الأرشيف، الرسمي منه والخاص، أسوق لهم هذا الخبر العجيب «الطازج» قبل أيام:
ففي عملية سرّية نفّذها الموساد الإسرائيلي، تمّ نقل نحو 2500 مستند وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين، إلى داخل إسرائيل.
مراسل شبكة «العربية» ذكر أن إسرائيل حصلت على مئات الوثائق والمقتنيات الشخصية التي تعود لكوهين احتفظت بها المخابرات السورية ضمن أرشيفها الرسمي، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة أنّه «تم جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بكوهين إلى إسرائيل، الذي يحتوي على آلاف القطع الأثرية التي كانت محفوظة بطريقة سرية للغاية من قبل قوات الأمن السورية لعقود من الزمن».إسرائيل تنظر إلى جاسوسها الشهير في سوريا نظرة احتفائية (هناك مسلسل عنه في «نتفليكس» قام ببطولته الممثل البريطاني اليهودي الشهير ساشا كوهين)، لذلك تُعدّ العُدّة للاحتفال بالذكرى الستين لإعدامه في 18 مايو (أيار) 1965. هذا الإعدام الشهير الذي تمّ في الساحة الرئيسية في المرجة بدمشق.
نتذكر في الأيام الأولى بُعيد هروب نظام الأسد، وتسلّل رئيسه بشّار وأفرادٌ معه إلى الحماية ثم للطائرة ثم للعاصمة الروسية، حدث هجوم من الكثيرين على مقرّات أمنية وأراشيف رسمية… هل نتوقع أن كل هؤلاء الهاجمين كانوا من عامّة الناس فقط؟!
بعد سقوط نظام القذّافي في ليبيا حصل أيضاً هجوم على الأرشيف الليبي، وما أدراك من أرشيف وتسجيلات العقيد الأخضر القذّافي وعجائبها؟!
كما حاولت أطرافٌ ما فعل الشيء نفسه على الأرشيف الرسمي الأمني أثناء الفوضى التي صاحبت خلع مبارك من حكم مصر واشتعال الشارع وهروب المساجين («حماس» و«حزب الله» وخلايا الإخوان التي كان لها فصولٌ ساخنة في هذا الأمر).
إذن الأرشيف هو غنيمة وثروة كبيرة، لا تقلّ إن لم تفُقْ، غنائم المال والذهب والسلاح، إنها المادّة الخام التي تشكّل الذاكرة، أو نحتْ هذه الذاكرة على هوى النحّات.
كما أن الأرشيف يُخلّد من يُراد تخليده بصورة احتفالية، عبر الحصول على أشياء مادّية تتعلق به، سواء أوراقه أو ملابسه أو حاجاته، كلها تخلق علاقة مباشرة بهذا الرمز التاريخي أو ذاك، كما فعلت إسرائيل مع أشياء جاسوسها، أو بطلها، الإسرائيلي في سوريا، كوهين.
سؤال أخير عن الأرشيف العربي: كيف حاله؟!
الشرق الأوسط
————————–
العناية بسورية، البلد غير المحبوب من أهله/ ياسين الحاج صالح
بحثاً عن حبٍّ للبلد يفوق كراهية حُكّامه أو قطاعات منه
19-05-2025
يكره سوريون مختلفون حُكَّامهم أو قطاعات من مجتمعهم أكثر مما يحبون بلدهم، بينما تبدو فرص سورية في البقاء اليوم رهناً بأن يزيد عددُ وأثرُ من يحبون البلد ويعتنون به على من يكرهون الحاكمين أو هذه الفئة أو تلك من السوريين. نتقدم هناك بادعاء غريب: سورية بلد غير محبوب من قبل سكانه لأسباب مختلفة. لبنان ليس كذلك، ومصر ليست كذلك، وتونس ليست كذلك، ولا يبدو أن أياً من دول الخليج كذلك، ولا الأردن الذي يُجايل الكيانَ السوري عمراً، ويشبهه من حيث آليات النشوء. ربما العراق يشبه سورية، وربما ليبيا.
وهنا محاولة للنظر في بعض جذور هذا الوضع المؤسف.
سورية استقرت على شكلها الحالي عام 1943 بعد عدة تجارب من الفرنسيين في تشكيل عدد من الدول منها. كانت قبل الانتداب الفرنسي جزءاً من السلطنة العثمانية، تتفاعل أقسامه المختلفة مع أجزاء واقعة اليوم في بلدان أخرى. كانت حلب على طريق الحرير، ميناؤها هو اسكندرون الواقعة اليوم في تركيا، وغير قليل من تبادلاتها التجارية مع الموصل الواقعة في العراق. هذا بينما كان ميناء دمشق الواقعة على طريق الحج هو حيفا الواقعة اليوم في إسرائيل، وكانت المدينة تُتاجر مع الحجاز وتقصدها قوافل التجارة البعيدة من الهند وفارس عبر العراق.
خاض السوريين كفاحهم ضد الفرنسيين كعرب، وكان إبراهيم هنانو الكردي الأصل وسلطان باشا الأطرش، الدرزي، يخاطبان السوريون بعبارات من نوع: أيها العرب! كان مُدرَك العرب استيعابياً يُتيح تجاوز انقسامات الدين والمذهب في بلد خرج لتوه من تحت الحكم العثماني، ويحاول الفرنسيون التلاعب بتنوعه الأهلي. لكن كان ذلك ينطوي سلفاً على عدم تطابق بين وعي الكيان وواقعه. وبعد استقلالها لم تستقرّ سورية على حال فكري نفسي يتوافق مع كيانها الناشئ، بل اتّسعَ التفارُقُ وبلغَ حدَّ الانفصال مع الوحدة مع مصر ثم الحكم البعثي. الوحدة كانت انفصالاً للسوريين عن سورية، وفناءً للبلد في دولة أكبر. وهي تدل على مَنزَع متطرف في تكوين سورية، لم نواجهه نحن السوريون يوماً ولم نُقرّ به، بل وأَوهمَ كثيرون بيننا أنفسهم أن سورية معتدلة ووسطية (في بالهم دمشق ربما، وهذا الاختزال نفسه مؤشرُ تَطرُّف وليس مؤشرَ اعتدال). القوميون العرب كرهوا الاستعمار وأحبوا الأمة العربية، لكنهم لم يحبوا «القطر العربي السوري»، بل وأنكروا شرعية وجوده وأقاموا شرعية حكمهم له على هذا الإنكار الذي شاركهم فيه غير قليل من «الشعب العربي في سورية». الحكم الأسدي أحبَّ نفسه ودوامَ سلطته، وكره خصومه السياسيين، وبخاصة الإسلاميين، كُرهاً استئصالياً. وعاقبَ حافظ الأسد مدناً بحالها مثل حلب وحماه وإدلب لأنها لم تحبه أو تمردت عليه، وكان هو مَعقِدَ حُبِّ السوريين المُفترَض، لا البلد ولا مدنه ولا ثقافته ولا مجتمعه المتنوع. وبالمقابل، كره كثيرون حافظ وبشار الأسد ونظاميهما أكثر مما أحبوا البلد، وهو ما يثير أسئلة بشأن دوافع كرهٍ للأسدَيْن قد لا تُحيل إلى العناية البلد والارتباط به. ومنذ الآن نرصد في النبرات وفي الأقوال الصريحة كُرهاً للفريق الحاكم اليوم، لا يبدو أنه تحفزه غيرة على سورية أو حرصٌ عليها.
وأحبَّ الشيوعيون السوريون الطبقة العاملة والاتحاد السوفييتي والعقيدة الشيوعية، وليس سورية. وحتى حين ظهرت شيوعيات سورية أقلُّ سوفييتية، فإنها إما وقعت في كُره النظام أكثر أو في عشق نفسها أكثر، ولا نجد في سجلّاتها ما ينظر في تكون سورية باحترام وحرص. وأحبَّ الإسلاميون الإسلام والأمة الإسلامية وماضي المسلمين، وليس سورية أو هذا البلد أو ذاك من بلدانهم، وليس الزمن الحاضر. وهم كرهوا الحكم البعثي والأسدي من كل قلوبهم، لكنهم لم يَعرِضوا حِرصاً على إطار سوري جامع، ولا احتراماً أو حسّاً بالإخوة مع أي من السوريين غير المسلمين، وغير الإسلاميين. وحتى القوميون السوريون الذين وحدهم يحملون اسم سورية في اسمهم، كانوا يحبون أنطون سعادة وبشار الأسد، ويكرهون «يهود الداخل»، أكثر مما يحبون سوريتهم الكبرى ومجتمعها وتَنوُّعها.
ولا يكاد يكون لسورية نصيبٌ من التقدير عند النخب الثقافية، وقليلة هي الكتب التي كُتبت عن سورية بروح إيجابية، حتى وإن انتقدت الكثير من أوجه حياة السوريين. المثقفون نقديون، هذا تعريفهم وواجبهم، لكن يَفترِضُ المرء أننا ننتقد من أجل وجود وحياة أفضل في الإطار السياسي الذي نعرفه أكثر من غيره وننشط فيه، ونتعرض فيه لأشكال من التمييز والعقاب والكره. هذا الإطار هو سورية لا غيرها، لأنه يحضن من أوجه حياتنا أكثر من أي رابطة أخرى من روابطنا. وخلافاً لدمشق أو للشام التي تبدو موضعاً مناسباً للقصائد والأغاني، تبدو سورية مضادة للشعر، وهو فن قريب إلى الحب؛ ولم تدخل الأغاني، وهي فن الحب أكثر من غيره، إلا في عهد حافظ الأسد، لكن حصراً بوصفها «سورية الأسد». وبين النخب الاجتماعية هناك من يحبون مدينتهم دمشق أو يحبون مدينتهم حلب، أو حمص أو دير الزور، لكن سورية لا تبدو موضوعَ استثمارٍ عاطفي وانفعالي. وهناك بعد ذلك من يحبون عشيرتهم، ومن يحبون طائفتهم، ومن يحبون دينهم، ويكرهون غيرها من العشائر والطوائف والأديان، مما يُبقي سورية إطاراً مُجرَّداً لجماعات متنوعة، ليس مُنافِساً على الحب أو جديراً به.
ولم تعرف سورية خلال ما يزيد على قرن من قيام كيانها الحديث مؤسسة عامة تتجسد فيها الوطنية السورية، شيء يشبه الجيش في مصر، أو السلالات الملكية في الخليج، أو الصيغة الميثاقية في لبنان (على علّات هذه المؤسسات الجامعة كلها). بأثر ذلك ظلت سورية كلمة مُعلَّقة في الفراغ، وظلت صفةُ الواحد منا كسوري لا تقول شيئاً مهماً عنه أو عنها. ما يقول شيئاً مهماً يغلبُ أن يكون العائلة أو الطائفة أو المَحلَّة. وهذا بذاته عائدٌ إلى ضعف الكيانية السورية ووهن التماهي بها. نتماهى بمن وما نحب، وليس بما لا نبالي به. وغير المؤسسات، ليس هناك رموز سورية جامعة، وفي سنوات صراعنا الطويلة بعد الثورة، تداعت الإجماعات المفروضة حول العلم والنشيد، وتكفَّلَ الواقع بتداعي الليرة السورية كلغة تبادل مادي جامعة.
وفي المحصلة تبدو سورية إطاراً عارضاً لوجود السوريين، بلداً يصادف أنهم ولدوا فيه دون أن يُسبِغوا قيمة إيجابية على هذه المصادفة، أو يَنسبوا لها معنىً يتعارفون عليه. وحتى في بلدان المهجر السورية خلال السنوات العشر الماضية، ليس شائعاً أن تكون سورية هي عنوان التلاقي بين سوريين لم يكونوا على معرفة ببعضهم. تتقدم على الصفة السورية صفات دينية ومحلية، أو شبكات صحبة ضيقة.
ولا يفوتنا أن الكلام على حُبّ الوطن خطير لأنه اقترن في التاريخ الحديث بالشوفينية أو التعصُّب الوطني وكره الأجانب، ولأنه يمكن أن يسلم نفسه بسهولة لسلطة الدولة، تراقب مُسلَّحةً به الأصوات المنشقة والنقدية وغير المتوائمة. لكن سورية أقرب إلى حالة متطرفة من غياب التوظيفات العاطفية والفكرية الإيجابية في كيانها ومجتمعها وتنوعها، مع بقاء كراهيات متنوعة، مُوجَّهة نحو الداخل والخارج، مُعتمِلة في نفوس أكثرنا. التطرف السوري قاد السوريين للهرب في كل اتجاه بعيداً عن مساحتهم الجامعة، نحو ما فوق هذه المساحة من أمة عربية أو إسلامية، وهو ما تجسَّدَ مرة في انفصال السوريين عن سورية وانحلالها في مصر كما تَقدَّم، مثلما تجسَّدَ لوقت طويل في إنكار لشرعية وجود البلد بوصفه كياناً مصطنعاً، مما أضعفه أمام نخب سلطة جعلت منه إقطاعة حزبية، ثم عائلية. كما تجسَّدَ أيضاً في أشكال من التطرف الديني لم تجد ما يُعدِّلها أو يحد من إطلاقها من كيان يحظى بقدر من إجماع سُكّانه. ثم إنه يحاول أن يتجسد اليوم في مَنازِعِ انفصال، تعبر عن نفسها علناً بلغات مشحونة بالكُره، وتستدرج ببسالة عروض حمايات أجنبية. هذا الهروب المتكرر من الجسد السوري يعطي الانطباع بأن قليلين منا يشعرون بالارتياح فيه.
ويبدو في الواقع أن في تكوين بلدنا شيء وعرٌ ونازعٌ إلى الذهاب بعيداً مثل ولد نشأ يتيم الأبوين، وعانى كثيراً في طفولته، فصار برّياً، جانحاً، صعبَ القياد. وهو ما لم يَجرِ تَدارُكُه في أي وقت بالتعامل اللطيف والودود مع البلد في تنوعه، أي مع سياسة تنوعه على نحوٍ يصون وحدته وفُرَصه في البقاء. وفاقمَ من ذلك أن السوريين قلما يعرفون بعضهم، وقد تكون نسب من زاروا مدناً وبلدات أخرى، بخاصة في الأطراف. من الأدنى عالمياً (أين الدراسات الإحصائية في هذا الشأن؟). هذا ليس للقول إن التطرف السوري نتاج الجهل، فهو وليد النشأة الوعرة للكيان، وفرط مركزيته، ثم مزايدات أبنائه على بعضهم حتى الموت، لكن الجهل فاقمَ التطرُّفَ الكياني ورسَّخه. ولعل فرط المركزية السورية ناشئٌ عن افتقار البلد إلى مركز طبيعي جاذب يتماسك حوله.
صعوبةُ قيادِ سورية تعني بالضبط صعوبة قيادتها وسياستها. يكاد بلدنا العسير يكون مستحيلَ الحكم. حافظ الأسد جاء من هذه الاستحالة، وليس من تكوين شرير فاسد، مُتأصِّلٍ في منبته العائلي والطائفي، هذا وإن يكن حبه لنفسه وعائلته أكثر من حبه للبلد الذي يحكمه قد آلَ بسورية أن تصير أشدَّ استعصاء على الحكم. ولذلك فإن من شأن استمرار قلة العناية بالبلد ومجتمعه وناسه المتنوعين أن يُديم عُسرَ القيادِ والقيادة، وأن يُنتج حافظ أسد جديد، أو يتسبَّبَ في انفراط البلد نهائياً.
كانت الثورة السورية أكبر حدث في تاريخ البلد مُوجَّه سورياً، تَطابقَ في جذعها الأصلي البلدُ كإطار لحياة السوريين مع وعيهم الذاتي لأنفسهم كسوريين. وهي واقعة تستحق إبرازاً أكبر، ويمكن أن تكون تجربة مؤسسة لسورية جديدة جامعة، تُخرِجُ الكيان السوري الجامع من التنازع السياسي الخاص، الديني والإثني والطائفي، لتجري المنازعات المحتملة في سورية وليس عليها.
ولا بد من الإلحاح على أن أهم التوظيفات العاطفية هي ما يأتي من الحاكمين والأقوياء. هؤلاء من يتعيّنُ عليهم أن يُبرهنوا على حب غير مشروط لبلدهم وشعبهم (وليس تَوقُّع الحب من مَحكوميهم أو فرضه عليهم مثلما فعل الأسدان)، هُم من ينعكس حبهم للبلد واحترامهم لأهله وعنايتهم بهم أجواءً إيجابيةً عامة. أظهر عموم السوريين إيجابية حيال بلدهم في أوقات الانتقال، بما فيها وقتَ ورثَ بشار أبيه، ثم وقت سقوط النظام، لكنهم لم يَلقوا إيجابية مُقابلة من الوريث قبل ربع قرن، والإيجابية الأولية التالية لسقوط النظام شهدت انحساراً منذ آذار الماضي، وهي إن كانت تشهد صعوداً بعد وعود رفع العقوبات، فإنه يُحتمَل أن تبقى متموجة لوقت أطول. هذا بينما شهدنا «ثورة» في الانفعالات والكراهيات في بضع الشهور الأخيرة، على نحو يُوحي باستبطانِ عدم استحقاق السوريين المتساوي للاحترام، وعدم استحقاق حيواتهم لاهتمام متساوٍ، ودوماً قلة عناية بالإطار السوري الجامع. لكن يبقى الأساس الصحيح للحد من الضغائن الفئوية والميول النابذة هو السلوك الجاذب والاستيعابي من قبل من هُم في السلطة.
المشكلات الاجتماعية والوطنية لا تُعالَج بالحب والدعوة إلى الحب؛ تُعالَج بالتصدي لجذورها على أسس من المساواة والاحترام. وليس في المسالك اليومية الأكثر لطفاً، والأقل عدوانية، ما يتعارضُ مع المعالجات الجذرية، بل العكس. الخشونة والعنف اللفظي ودعوات القطيعة يغلب أن تكمن وراءها تطلعات فئوية أو فردية خاصة.
في مفصل تاريخي اليوم، حيث كثير من النفوس غضّة وحيث الوقائع غضّة بعض الشيء، الوقت ملائم للكلام على العناية بالبلد وإيجابية السوريين المبدئية حيال بعضهم والتقليل من منسوبات الكُره العالية. المسألة ليست أن نحب سورية حباً غير مشروطٍ بحقوقٍ أو كرامةٍ أو عدالة، بل فقط أن نحبها أكثر مما نكره حاكميها أو قطاعات من شعبها، بحيث يكون مُسوِّغُ أي كره خاص هو إعاقة المكروهين للتحسّن العام.
موقع الجمهورية
—————————–
ما الذي تغيّر فينا وفي دمشق الخارجة من الحرب بعد 6 أشهر؟/ أحمد جاسم الحسين
2025.05.19
كنت في دمشق في الأسبوع الأول من سقوط النظام المخلوع، بعد غياب نحو 12 عاماً، وها أنا أعود ثانية بعد نحو 6 أشهر، شوقاً وتحضيراً للعودة النهائية في هذا الصيف، كما يفعل عدد من السوريين!
دون أن تجهد نفسك ستأخذك أفكارك إلى المقارنة بين ما كان وما هو اليوم، ستبدأ من المعبر الحدودي: مطاراً أو حدوداً برية: ستجد علم بلادك، وكذلك موظفين باتوا يعرفون ماذا يعملون بخبرات معقولة، وستلفتك هذه المرة سهولة الإجراءات، تحاول أن تختبر مشاعرك، يعلو زهو في داخلك: بات لدي بلد كما الآخرين ، لا أخاف منه! تجرب أن تمشي قدماك بثقة ابن البلد، ابن الأرض!
في المرة الأولى قيل لك: تفضل! يا إلهي كم كانت صعبة سهلة، تلك البلاد الممنوعة عنك والخائفة هناك من يقول لك: تفضل! بلاد دون خوف؟ دفعة وحدة تفضل، ألا تختمون جواز السفر؟
كما تريد!
هل تريد أن نختمه؟
ويلتاه ما هذا؟ أنا من يحدد النظام، لا، لا، أريد الدولة أن تحدد لي وتقرر عني، أريد أن أختم جوازي الهولندي، لا أريد مساءلة من دولة ديمقراطية حين أعود، أريد أن أقول لهم دخلت وخرجت إلى بلدي الأم من الحدود وبوضوح، لا أحبُّ السرية في التعامل مع الدولة، أرغب أن أتعامل معها بوضوح وشفافية وصراحة، إنْ كنتُ مخطئاً فلتحاسبني، وإن كنتُ مصيباً فلتتركني بحالي، وما المخالفة في زيارة بلدي الأم الذي حرمت منه 12 عاماً! ولاحقتني كوابيسه؟
استقرار سعر صرف الليرة السورية، وكذلك الثقة بأن التغيرات في حدود المعقول يجعل الاتفاق مع السائقين أكثر واقعية، تطبيق “يالله نوصلك” يمكن أن تلجأ إليه بسعر أقل بنحو 30 بالمئة من سعر التكسي، وكما التطبيقات العالمية ليس السبب هو السعر وحده، بل قلة وجع الرأس، أنا من الأشخاص الذين يفضلون التكسي التقليدي هنا وفي القاهرة، لسبب بسيط، في التكسي العادي أنا أدفع للسيارة والحكواتي الخبير، أما في سيارات التطبيقات فهناك أشخاص غير محترفين، مهمتهم التوصيل فحسب! وكلما احتجت إلى التكسي أبادره بالسؤال: ما الذي تغير في دمشق؟ يرد كثيرون: دمشق لم تتغير، نحن الذين تغيرنا!
لا يفوت أي زائر لدمشق اليوم أن حركة المرور صارت أسهل وأكثر قانونية، هنا في دمشق القوانين مرنة أكثر من الدولة، في هولندا القوانين والدولة حادتان، غير أن القوانين في هولندا تقر من الأدنى إلى الأعلى وبعد دراسات تحقق مصلحة الأكثرية، في بلادنا تقر القوانين من الأعلى تحتاج إلى أسابيع حتى تعتادها، فالتجاوز من اليمين واليسار، وإعلام السائق برغبتك بتغيير المسار يقوم على النية، “متى ما نويت تقدر”! لكن في هولندا، عليك أن تدرس المشهد أولاً ثم إن كان يسمح لك تقوم بالتنفيذ. قوانين السير طرائق تفكير كذلك، في هولندا التخطيط يسبق التنفيذ، في سوريا القرار أولاً والتنفيذ يعني الاستنفار والتحدي، هو نوع من المقارنة بين بلاد انتهت من بنيتها التحتية قبل 75 عاماً وبلاد خارجة من الحرب، لا يمكن الموازنة بينهما!
الأرصفة حدثتني أنها لا تحب المقيمين، بل العابرين، يكونون خفيفي الأقدام، اليوم الأرصفة متعبة لكنها سعيدة، وقد نجد مقيماً عليها ينتظر ذهاب دورية الشرطة كي يبسط جواربه، في منطقة فكتوريا تجد من أحضر معه النعناع البري أو الزعتر أو الفاصوليا المقشرة أو الفول، تسأله من أي قرية أنت يقول لك: من دير العصافير!
أما أسعدُ الأسواق فهو الحميدية، منذ سنوات خفت “البسطات” إلى النصف، هناك ما يشبه لعبة القط أولفار بين الدوريات وبائعي البسطة، الذين باتت لديهم طرقهم في الإعلان عن بضائعهم أو في “التبسيط السريع” والهروب السريع!
أتاح بسط سلطة الدولة أن يكون هناك مكان لقدميك أو أمتار خلفك أو أمامك، ثمة فراغ وفسحة، وبات يمكن لعائلتك أن ترافقك دون أن يقولوا لك في نهاية المشوار: لبتنا لم نأت!
حق الناس في المشي المريح لا يفهمه كثير من بائعي البسطات، وجزء منهم يرتبطون بالمحال أو تسويق لمنتجاتها! ما يهمهم هو بيع منتجاتهم، وثمة صراع خفي بين من يركض للربح أو لتأمين لقمة العيش، ومن يأتي ليمشي، يرى الأول في الثاني “فاضي بال” وربما زبوناً محتملاً، ويرى الثاني في الأول معيقاً للمتعة وباحثاً عن مصلحته وحسب، حتى لو أزعج حركة المرور. بناء المواقف والتصورات يرتبط مرات كثيرة بالحاجات أو الدوافع أو الأهداف!
الأرصفة تفتح عيونها كل صباح تنتظر إعادة الإعمار فقد أنهكتها الحُفر والتكسير والإهمال، كأن السلطات القديمة كانت تؤجل تسليم البلاد إلى قيادة جديدة، لكنها قبل ذلك حاولت أن تمتصها حتى آخر لحظة، دون أن تحرص على صيانتها، كأنها استلمت البلاد وتريد أن تسلمها بالوضع الراهن، حتى لو كانت مكرسحة، معاقة الخدمات، وبدلاً من أن تكون مهمة السلطات الجديدة متابعة المسار والتطوير إلا أنها ستقف في مكانها عاجزة وتنشغل سنوات حتى تعيد للأرصفة والحياة عامة في سورية سبل بداية صحيحة وتنتشلها من القاع إلى الدرجة صفر لعلها تنطلق من الصفر!
اليوم، في دمشق الكثير من الثقة في العيون، ربما الأحوال الاقتصادية تنتظر الأيام القادمة، لكنها مستبشرة، تحمل الأمل في عيونها، يقول لك كثيرون: القادم أفضل، مرحلة صعبة علينا أن نتحملها ثم ستنطلق البلاد!
يخطر ببالك سؤال غشيم: هل كانت البلاد في أيام النظام البائد أحسن؟ يلتف الشخص يمنة ويسرة ليقول لك: ربما كانت مستقرة على الخراب! كانت تمشي نحو الناهية، ومرات كثيرة يكون المشي نحو الناهية أكثر استقراراً من التغيير! لكن الناهية قادمة لا محالة، لذلك تغيير متعِب قبل النهاية أفضل من نهاية مفجعة!
يحاول شخص عابر أن يضيف بعد أن شغله الحوار فيقول: بالمفهوم اليومي كانت الكثير من الأمور مستقرة تحت مظلة الخوف والقمع والتشليح والإتاوات، إنه نوع من استقرار الخراب، لكن اليوم بالمفهوم الاستراتيجي سيكون الوضع أفضل بعد أسبوع أو شهر أو ثلاثة شهور أو سنة، خرجنا من القمقم والصندوق الأسود وبات العالم يرانا!
يلفت نظر من يراقب لباس السوريين اليوم أنهم خارجون من حرب، من بلاد تعد اللباس درجة ثانية لأنها منشغلة بلقمة الخبز، بعد أن خربها الديكتاتور المخلوع، أبرز تغير تلحظه اليوم في وجوه الناس خطواتها، في محاولة الكثيرين إعادة النظر في خطط حياتهم أو مشاريعهم “الأمل”، وما أدراك ما الأمل بعد أن عشعش اليأس في حياتهم!
بدا على كثير من السوريين استحضار خطط للبدايات الجديدة، هذا كان لديه حب مؤجل، وذاك زواج مؤجل، وآخر بيت لم تكتمل كسوته، وآخر خبأ قرشه الأبيض ليوم أسود قادم لا محالة في ظل النظام القديم، بات اليوم يخرجه وهو يأمل أن الأيام السود قد انتهت لذلك سيحفر البلاطة ويخرجها ليوصل إطلاقة الشمسية أو يعيد نفض بيته أو تغيير طقم الكنب فيه مثلاً، يريد السوريون اليوم قطع علاقتهم نهائياً بذلك اليوم الأسود، فالأولاد لم تعد لديهم عسكرية إجبارية، والاعتقال تعسفي يأملون أنه صار من الماضي، وكل ما عدا ذلك يقبل الحل! الكهرباء يمكن تعويض فاقدها من الطاقة الشمسية، والماء يمكن توفير استهلاكه، وطبخة اليوم تكفي ليومين إن كان بجانبها خضراوات تملأ المعدة!
تحاول البلاد اليوم أن تعيش في جو جديد اسمه اللاعقوبات الدولية، أن تستلهم منه الأمل، لا تمسك شيئاً بين يديها لكن الأخبار وحدها يمكن أن تهزم اليأس كذلك!
السوريون لديهم علاقة خاصة مع الأمل واستمطاره وتوليده وزراعته، وها هي الظروف مهيأة اليوم ليعيش ويدفعهم للبحث عن نقاط مشتركة فيما بينهم، ويتشاركون في زراعة مساحاته وتقليص مساحات اليأس!
لو أعدنا السؤال مرة أخرى: ما الذي تغير في سوريا وما الذي تغير فينا بعد ستة أشهر؟
نقول: بتنا نفهم بعضنا بعضاً أكثر، ونتفهم ظروف كل منا، وهناك إمكانية لنحدث عملية إعادة اندماج بعد فراق طويل وتغير ظروف كل مناو تبدلها، وننظر معاً إلى مستقبل بأمل أكبر ويأس أقل!
————————————-
النقد.. والنقد البنّاء/ حسام جزماتي
2025.05.19
يعرف متابعو الأدبيات السياسية العربية الحديثة أن عنوان هذا المقال ليس جديداً في هذا الحقل. بل مكرر إلى حد في وثائق الأحزاب القومية اليسارية على وجه الخصوص، ومنها حزب البعث، قائد الدولة والمجتمع والعقل والمعايير وكل ما في الحياة العامة السورية التي كانت تزداد تصحراً بتناسب طردي مع اهتراء مفاهيمه وفقدانها لأي معنى.
لكن انفجار التعبير في البلاد، منذ سقوط البعث وعلى رأسه بشار الأسد، فتح أبواباً واسعة للنقد وما حوله، أدارت رؤوس المتابعين الذين صاروا يتساءلون عن ترند اليوم، والذي يمس غالباً أحد قرارات الحكومة أو تصريحات مسؤوليها أو مقابلات المشاهير. وقد أتعبت هذه الحيوية المفاجئة الفائقة نفوساً كانت قد نسيت حرية التعبير لعقود في مناطق النظام، وأخرى قد ضجرت منها وتراجعت جدواها عندها من سكان المناطق المحررة المتعَبة سابقاً.
ومن جهته صعد الحكم الجديد على آمال عريضة للغاية، وإمكانات شديدة العسر، وجمهور متحمس ضاق صدره بالشك في احتمال تحقق الأحلام أو الإشارة إلى مصاعب ذلك فبادر، بقواه الذاتية الفائرة وعبر إعلامييه شبه الرسميين والطوعيين، إلى محاولة إسكات كل صوت يفسد البهجة أو يضع العصيّ في عجلة الآمال الفياضة. لكن الجو العام سرعان ما تنبّه إلى أن ذلك غير جائز في عهدٍ عنوانه الحرية، فتراجع دعاة الإسكات خطوة إلى الوراء، واستعادوا، من دون أن يعرف معظمهم التاريخ، هذا التمييز القديم بين النقد والنقد البنّاء.
ومن دون تنظير على نهج البعثيين، انصرف معنى كلمة «النقد» إلى رفض مشروع الحكم القائم من جذوره، أو الإشارة إلى عيوب جوهرية غير قابلة للإصلاح فيه، أو يتطلب العمل عليها تغييرات بنيوية لا يستطيعها أو لا يريدها. في حين عنى تعبير «النقد البنّاء»، المفتوح على مصراعيه تقريباً، تنبيه الأجهزة الخدمية إلى انقطاع الكهرباء، مثلاً، لأسبوع عن هذا الحيّ أو ذاك، أو توعية السلطة إلى تسلل بعض الشبّيحة في دورات التطوّع في الأمن العام أو الشرطة أو الجيش. وصولاً، على الخصوص، إلى حملة استنكار مفتوحة تعمّ صفحات إعلاميين عند تعرّض أحد زملائهم للتعدي من دورية هنا أو هناك. ففي نهاية المطاف يتحدر المسؤولون المتوسطون والموظفون الجدد، والمؤثرون المتألقون الآن، من بيئات الثورة، ولا بد لهم من تلبية بعض متطلباتها والوفاء لمسيرتهم وذاكرتهم التي لم تمحُها الأيام بعد. ومناسبات كهذه فرصة ممتازة للقيام بهذه الأعباء، ومستند للتملص من تهمة «التطبيل» التي شاعت في وصف بعضهم ويحاذر من الوقوع في حماها الآخرون.
غير أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد. ففي مجتمع لم يعتدِ النقد تضيع حدود ما يعرّفه ويضبطه في فضاء سائب يحتمل أشكالاً مختلفة من التطرفات. فمن جهة أولى لا يتورع بعض الإعلام شبه الرسمي والرديف عن التحريض على أشخاص وجماعات، مما ترك آثاراً دامية فعلية بوجود جمهور كبير جزء منه مسلّح أو مؤثر في حاملي السلاح. ومن جهة أخرى يستخدم بعض واضعي المعايير وفق أهوائهم طرفاً من الآداب العامة، كرفع الصوت أو خفضه، لتجريم النقد وتجاهل قضيته المطروحة، بدعوى وبما أننا في دولة حديثة، أو هكذا نأمل على الأقل، فإن الضوابط الأساسية لنقد السياسيين أو المؤسسات يجب ألا تُستمد من أعراف المجالس التي يجب أن تحكم الحياة الاجتماعية فحسب؛ بل من مصدرين هما القوانين التي تضبط حدود التهديد بالعنف أو التحريض عليه أو التشهير، وأيضاً من مواثيق الشرف الإعلامية التي يُفترض أن تكسو الفضاء الصحافي المقروء والمسموع والمرئي بضوابط قانونية أو نصف قانونية أو مهنية تحدد مساحة التعبير المقبولة عن تلك الصفراء، بمعايير عالمية. وفي انتظار تحديث القوانين وتفعيلها، وهو أمر يحتاج إلى كثير من الوقت، لا بد من وضع الحِمل على العامل الثاني ونظائره، بأن تلتزم المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات مهنية واضحة شفافة صادقة لا يطغى عليها حماس ولا تخالطها محسوبية ولا يبطّنها تغاض.
وإذا كنا في مرحلة بناء سوريا من جديد، ووضع أسسها من النواحي كلّها، فإنه يجدر أن تتم هذه العمليات بأعلى قدر من ضبط النفس والقوى تجاه الرأي المخالف مهما بلغت جذريته أو نقده سلوكياتنا. وأن نعدّ كل ما لا ينتهك القوانين والمواثيق منه نقداً بنّاء أو، على الأقل، نقداً لا يستحق الإدانة والإخراج من الملة الدينية أو الوطنية. فلا يليق بحامل مشروع قوي منتصر أن يحسب كل صيحة عليه، وأن يبدو ضعيف الثقة بخطواته إلى درجة منع مراقبتها وتقويمها.
لا سيما وأننا ورثنا في هذه البلاد، نتيجة لعقود حكم الأسدين ولأسباب أخرى بعضها أقدم، تيارات شتى تتركّب على أقوام وطوائف وجماعات. ولا ينفع، لترميم النسيج الوطني الهش، أن نكون هشّين نحن أيضاً إلى هذا الحد. فمفاعيل عدم الثقة بالنفس ربما تجلت بردّات فعل شعبية حادة كما شهدنا مؤخراً في أكثر من منطقة. وهو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذه المرحلة، الحساسة فعلاً، من طورها الانتقالي من حالة الخراب إلى دولة مستقرة كما يتمنى الجميع.
تلفزيون سوريا
—————————–
حين يتحوّل الغضب إلى “ترند”/ أحمد عسيلي
19 أيار 2025
في غضون أسبوع واحد، عاش السوريون ثلاث هزّات نفسية متفاوتة: الزيارة المفاجئة للرئيس إلى فرنسا، وما أثارته من انقسام وجداني حاد بين من فرح بها وبين من عدها انتكاسة، ثم ضجة “ميرا وأحمد” التي اكتسحت وسائل التواصل ليومين متتاليين بكل ما رافقها من شحنات غضب طالت الجميع، وأخيرًا رفع العقوبات الأمرركية، وما رافقه من موجة فرح جماعي لم تستثنِ إلا القليل. هذه التحولات المتسارعة والمرهقة تستنزف الجهاز النفسي العام، وتخلق بيئة مشحونة يُستبدل فيها التفكير بالتفاعل، والسؤال بالانفعال، والتأمل بالاندفاع.
والواقع أن أيام السوريين منذ لحظة هروب الأسد من سوريا، أصبحت تتأرجح بين فرح عظيم، وحزن عميق، وخوف وترقّب، فهل يمكن تخيّل الطاقة العقلية اللازمة لعيش كل هذا في وقت متقارب؟ هل من المعقول أن يتمكّن أي جهاز نفسي من الصمود في وجه هذا التقلّب المستمر؟
وسط هذا المناخ المتبدل، اجتاحت الفضاء السوري الأسبوع الماضي حالة لافتة من الانقسام حول قضية بدت في ظاهرها “اجتماعية”، لكنها سرعان ما انزلقت إلى نقاشات عن الشرف، والهوية، والانتماء، والذكورة، والعار، بدأت القصة بخبر غامض عن فتاة تزور أهلها برفقة من قيل إنه اختطفها وتزوجها قسرًا، وسط حماية من الشرطة. ومع أن التفاصيل بقيت متضاربة، تحول الحدث سريعًا إلى ترند انفجاري، غصّت به المنصات بموجات من الغضب، والسخرية، والتحريض، والاتهامات المتبادلة.
لكن ما يهمّ هنا ليس الخبر ذاته، الذي استُهلك في النقاش حتى الابتذال، بل بُعدان يتجاوزانه:
الأول: ظاهرة الترند نفسها كملاذ نفسي في مجتمع مفكك ومثقل بالعجز.
الثاني: الآلية النفسية التي تجعل من المختلف خطرًا، ومن السؤال خيانة.
في البُعد الأول، سأحلل الظاهرة استنادًا إلى مفهوم طرحه المحلل النفسي الفرنسي أندريه غرين، يُعرف بـ”التفكير الأبيض” (la pensée blanche). يشير هذا المفهوم إلى حالة نفسية تكون فيها الذات غارقة في انفعال قوي (حزن، قلق، غضب)، لكنها عاجزة عن تحويل هذا الانفعال إلى فكرة أو خيال أو حتى صورة، يقف التفكير عند عتبة المشاعر، فيبدو العقل كصفحة مشحونة… ولكن بيضاء.
هذه الحالة نشاهدها كثيرًا في الممارسة العيادية، مريض يطغى عليه حزن أو قلق، ويعتقد أنه عاجز عن التعبير عن ألمه. لكننا نكتشف أحيانًا أن ما يشعر به هو مجرد شعور خام، بلا كلمات، بلا شكل، وهذه درجة أكثر إرباكًا من الحزن نفسه، حين يصبح الإنسان عاجزًا عن صياغة أحاسيسه، وهنا يجب أن أؤكد أن هذا النوع من “الفراغ” ليس خاصًا بأمراض الذهان فقط كما كنا نعتقد سابقًا، بل نشاهده حتى في إطار الاكتئاب واضطرابات القلق، بل وانخفاض المزاج.
في هذه الحالة، يصبح أي محتوى خارجي (صورة، فيديو، قصة) فرصة لإسقاط التوتر الداخلي، ليس لأنها تعبّر عنه بالضرورة، بل لأنها ببساطة تملأ الفراغ، وهكذا، يصبح الترند نوعًا من التخدير النفسي؛ بديلًا عن مواجهة الأسئلة المؤلمة، يندفع الناس إلى حدث يتيح لهم التفاعل والانفعال، دون الحاجة إلى فهم أو تحليل، فالمجتمع، كما الفرد، قد يعجز عن التفكير حين يُثقل عليه الألم.
أما البعد الثاني، وهو الأخطر: سهولة شيطنة الآخر المختلف، وتحويل السؤال إلى خيانة.
في قضية “ميرا وأحمد”، لم يتوقّف الغضب عند حدّه الطبيعي (وهو مبرر تمامًا عند الحديث عن عنف محتمل ضد فتاة)، بل تحول إلى هوس جماعي بصياغة رواية متخيلة: أحمد هو “أمير جهادي”، ميرا “سبية”، والشرطة “تسهّل السبي”. اللافت أن كلمة “السبي” لم تكن واردة في أصل الخبر، لكنها بدت وكأنها أُسقطت من الذاكرة الجماعية، كأنها كانت تنتظر فرصة لتخرج، تم استدعاء داعش (لا كواقع سياسي، بل كصورة للشر المطلق) بهدف إقصاء الآخر المختلف، وقولبته.
ما لبث الغضب أن تجاوز “الجاني المفترض”، وراح يُوجَّه نحو كل من تردّد، أو سأل، أو دعا إلى التأني، حتى لو لبضعة أيام فقط، لمعرفة حقيقة ما جرى، صار التساؤل خيانة، وتحولت المنصات إلى محاكم تفتيش تبحث عن “الخونة” بدل الحقيقة.
الخطورة لا تكمن في مضمون الرواية، بل في بنيتها النفسية: في رفض تعدد القراءة حتى للغة الجسد، في شيطنة الآخر، وفي عسكرة الاختلاف، لأننا هنا لم نكن نتحدث عن حقيقة بديهية كحقيقة أن بشار دكتاتور، أو واقعة شهدها الآلاف وموثقة بالصورة كرمي البراميل المتفجرة، أو جرائم الساحل السوري، بل رواية غامضة، كانت وقتها تحتمل، فعلًا ومنطقيًا، عددًا من التساؤلات، لكن جرى التعامل سريعًا مع هذه التساؤلات وكأنها أحد أشكال التواطؤ أو التبرير، وللأسف هذه البنية لا تقتصر على جماعة دينية، بل قد تتجلى أيضًا في أنماط يسارية أو قومية أو ليبرالية. التطرف، ببساطة، لا يسكن الأفكار، بل يسكن طريقة الدفاع عنها، والجانب المؤلم في القضية، أن موضوع الاختلاف نفسه يصبح كالعادة شيئًا جانبيًا يتبع الموقف السياسي، بل أحيانًا ننسى الضحية ذاتها لنتوه في دوامات من الاتهامات المتبدلة.
يبقى الأمل أن تكون هذه الموجات المتكررة من الانفعال مجرد فورات عابرة. لكن حجم التفاعلات، وسرعة التنقل بينها، وعمق الشروخ التي تخلّفها، تشير إلى هشاشة نفسية بنيوية. هشاشة تنتج جهازًا نفسيًا مرهقًا، سهل الانجراف، ومتعبًا من فرط ما حُمّل به من تحولات لا تهدأ.
عنب بلدي
———————————–
دمج الوحدات العسكرية في وزارة الدفاع.. الأبعاد والفرص والتحديات/ أحمد العكلة
18 مايو 2025
في تحول لافت في بنية المؤسسة العسكرية السورية، أعلن وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، أمس السبت، دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع، موجهًا تحذيرًا واضحًا إلى المجموعات العسكرية الصغيرة التي لم تندمج بعد، بضرورة الامتثال خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام. ويمثّل هذا الإعلان خطوة مهمة نحو توحيد القرار العسكري وفرض هيبة الدولة على جميع القوى المسلحة داخل الأراضي السورية.
جاء الإعلان عبر منصة “إكس”، وتضمن ثلاث نقاط رئيسية: دمج جميع الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، بما في ذلك الوحدات المستقلة والمجموعات شبه العسكرية، وتحديد مهلة زمنية أقصاها 10 أيام لالتحاق المجموعات الصغيرة التي لم تنضم بعد إلى الوزارة، والتحذير من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات التي تتخلف عن الانضمام بعد المهلة المحددة، استنادًا إلى القوانين العسكرية السورية.
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وما حققته الإدارة السورية الجديدة من اختراقات دبلوماسية، جاء قرار دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع ليطرح تساؤلات جوهرية حول أبعاده السياسية والعسكرية، وانعكاساته على المشهد السوري.
يرى العقيد والخبير في الشؤون العسكرية، مصطفى الفرحات، أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد الانفتاح الذي حققته الإدارة الجديدة على المستويين العربي والدولي، لا سيما عقب القمة التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع. وقد أعادت هذه التحولات سوريا إلى المسار العربي والدولي، ما انعكس مباشرة على الداخل السوري، بما في ذلك المؤسسة العسكرية.
تحديات التنفيذ: الولاءات الخارجية والوضع الأمني
يشير الفرحات إلى أن دمج الوحدات العسكرية يشكّل خطوة استراتيجية نحو استعادة وحدة الدولة، ويجسد رغبة القيادة الجديدة في فرض هيبة الدولة من خلال “بندقية وطنية واحدة”، بعيدًا عن فوضى التسلح والانفلات الأمني.
يوضح الفرحات أن وجود قيادة مركزية واحدة تتبع لها جميع الفصائل العسكرية يعزز من فعالية المؤسسة العسكرية، ويساهم في توحيد القرار العسكري. ويؤكد أن استمرار وجود فصائل مستقلة أو خارجة عن إطار الدولة يهدد تماسك الجيش، كما حدث في تجارب بعض الدول العربية، مثل العراق ولبنان، حيث أضعف وجود ميليشيات موازية هيبة الدولة. وبالتالي، فإن دمج الفصائل تحت قيادة الجيش السوري يشكّل حجر الأساس في بناء مؤسسة عسكرية متماسكة، تخدم الدولة فقط دون انقسامات أو ولاءات فرعية.
يعتقد الفرحات أن التوجه الجديد لا يسعى إلى دمج المجموعات ككتل مستقلة، بل إدماجها كأفراد داخل الوحدات النظامية، تجنبًا لتكرار سيناريوهات الانشقاق والانقسام. ويوضح أن الدولة تسعى إلى إذابة هذه التشكيلات داخل الجيش، مع الحفاظ على الهيكل العسكري المركزي القائم، ما يعزز من قوة الجيش واستقراره على المدى الطويل.
يشير الفرحات إلى أن وجود تحديات فعلية، خاصةً أن بعض القوى المسلحة المدعومة من أطراف خارجية لا تزال تسعى إلى فرض واقع سياسي من خلال نفوذها العسكري. ويشدد على أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمثيل كافة المكونات ضمن مؤسساتها، ولكن بعيدًا عن منطق المحاصصة. ويؤكد أن الرئيس أحمد الشرع كان واضحًا في تأكيده على وحدة الجغرافيا السورية، والمساواة بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات.
يعتقد الفرحات أن القرار يمثّل بداية فعلية لنهاية نفوذ بعض التشكيلات العسكرية غير النظامية، خاصةً تلك التي تتلقى دعمًا خارجيًا من دول عدة، مثل إيران التي لم تستسغ الانعطافة السورية نحو المحور العربي والغربي. كما يشير إلى أن ضبط التمويل واللوجستيات العسكرية عبر الدولة يضمن خضوع هذه القوى لسلطتها، ويمنع حدوث اختراقات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
ويرى العقيد الفرحات أن ما تقوم به الإدارة الجديدة يعد خطوة جريئة ومدروسة، تهدف إلى ترسيخ وحدة القرار والسلاح، وإنهاء ظاهرة التعدد العسكري التي أنهكت الدولة لعقد من الزمن. وعلى الرغم من التحديات، إلا أن السياق السياسي والدعم العربي والدولي يشكلان فرصة تاريخية لإعادة بناء الجيش السوري كمؤسسة وطنية موحدة.
مخاوف وصعوبات لوجستية
وشهدت سوريا خلال سنوات الحرب تفككًا واضحًا في البنية العسكرية، وتعددت القوى المسلحة على الأرض، بما في ذلك فصائل رديفة، وميليشيات محلية، وقوى مدعومة من أطراف خارجية. وفي الأشهر الأخيرة، ومع التوجه نحو استعادة سيادة الدولة على كامل التراب الوطني، عملت الحكومة السورية على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وضبط السلاح، وإنهاء التعددية المسلحة خارج إطار الجيش الرسمي.
وتسعى الوزارة إلى توحيد القرار العسكري والسياسي داخل البلاد، وتحقيق ضبط كامل للسلاح غير النظامي، ومنع أي مظاهر للتسلح خارج إطار الدولة، وتحسين الكفاءة والانضباط العسكريين ضمن القوات المسلحة، وتهيئة الظروف لمرحلة إعادة الإعمار من خلال مؤسسات أمنية موحدة، إضافةً إلى الحد من التدخلات الخارجية في الشؤون العسكرية الداخلية.
ويرى الخبير السياسي فيصل السليم أن التحديات المحتملة تشمل رفض أو تباطؤ بعض الفصائل في الانضمام الكامل، خاصةً تلك التي ترتبط بولاءات خارجية، في ظل حساسية الوضع الأمني في بعض المناطق التي لا تزال خارج السيطرة التامة للجيش السوري.
وأضاف في حديث لموقع “الترا سوريا” إلى وجود مخاوف من اشتباكات أو توترات محلية إذا لم يتم دمج بعض المجموعات بطريقة تدريجية ومتوازنة، مع صعوبات لوجستية وإدارية في إعادة هيكلة وحدات كبيرة ومتشعبة تحت قيادة مركزية. ولفت إلى أن الخطوة قد تلقى دعمًا من مؤسسات الدولة وأنصار الحكومة، بينما قد تثير مخاوف أو تحفظات بعض القوى المسلحة المحلية التي تخشى خسارة نفوذها وامتيازاتها.
التحديات والبدائل المتاحة أمام الحكومة
وفي تصريح خاص لموقع “الترا سوريا”، أكد العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر سابقًا، أن الحكومة السورية تمضي قدمًا في مشروع دمج كافة الفصائل المسلحة ضمن هيكلية وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن خطوات كبيرة ومهمة قد أُنجزت بالفعل في هذا الإطار.
وأوضح الكردي أن هذا التوجه يحمل رسالة تحذيرية واضحة إلى التجمعات العسكرية المتواجدة في مناطق “قسد” والسويداء، مؤكدًا أن هذه المجموعات باتت صغيرة مقارنةً بالجيش المشكّل حديثًا، والذي أصبح يتمتع بقوام موحد وكبير.
وأضاف أن الدولة لن تقبل ببقاء أي سلاح خارج إطار الهياكل الرسمية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، أو أي مؤسسة حكومية أخرى تستدعي طبيعة عملها التسليح، مثل إدارة الجمارك، وإدارة التبغ والتنباك، ومديرية الموانئ، ومديرية الحراج، وغيرها. كما شدد على ضرورة إدراجها ضمن المنظومة العسكرية للدولة.
وأشار الكردي إلى أن إخضاع السلاح لسلطة الدولة يعد أولوية قصوى، محذرًا من أن أي فصيل يتلكأ أو يرفض تسليم سلاحه سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الدولة، مما سيؤدي إلى انقسامات داخلية بين مؤيد ورافض لهذا القرار.
ولم يستبعد العقيد الكردي أن تلجأ الدولة، في المرحلة الأولى، إلى فرض أطواق على المناطق الرافضة لتسليم سلاحها وممارسة ضغوط متعددة، لكنه أكد أن الخيار العنيف سيبقى مطروحًا في حال استمرار الرفض، وذلك بهدف إرغام تلك الفصائل على الانضمام إلى صفوف الجيش.
وختم الكردي حديثه بالإشارة إلى أن التسويات السابقة كانت مؤقتة، أما المرحلة الحالية فهي مرحلة “بناء الدولة”، مما يستوجب إخضاع جميع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة دون استثناء.
يمكن أن يُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لتعزيز السيادة السورية، وقد تراقب بعض الدول، خاصةً الداعمة لفصائل مسلحة، تأثير الخطوة على مصالحها ونفوذها في سوريا مع ضرورة توفير ضمانات قانونية وتنظيمية للمجموعات التي ستنضم لضمان دمج سلس وآمن، وتكثيف جهود الحوار والمصالحة مع القيادات الميدانية للمجموعات غير المنضوية، مع إشراك المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في عملية إعادة التأهيل، والتسريح عند الضرورة، وتوخي الشفافية في تطبيق القوانين لمنع أي تجاوزات خلال مرحلة الدمج.
ويعد قرار وزير الدفاع السوري خطوة محورية في بناء مؤسسة عسكرية موحدة وفعّالة بعد أكثر من عقد من الانقسام والصراع. ويعتمد نجاح هذا القرار على آلية التنفيذ، وردود فعل الأطراف المعنية، ومدى جاهزية الدولة لضمان الدمج السلمي والمنضبط لكافة القوى المسلحة. كما سيكون له أثر استراتيجي على مستقبل الأمن والسيادة والاستقرار في سوريا.
الترا سوريا
———————————————–
ملاحظات/ ماهر مسعود
سعيد جداً بإزالة اللافتات التي تمجّد الشرع في اللاذقية وفي عربين، قد يبدو الأمر بسيطاً وتفصيلياً، لكنه بالغ الأهمية كمسار يتم كسره منذ البداية.
كسر مسارات تأليه السلطة وعبادتها يبدأ دائماً بحالات رمزية بسيطة، والسلطة إما تقوم بتعزيز استعداد الناس الهائل للخنوع؛ لاسيما في مجتمعات منكوبة.. وبالتالي تساهم في صناعة ذلك الخنوع. أو تتصدى لتلك الظواهر وتعطي إشارات معاكسة، فتحرر المجتمع من قابليته الكامنة لتأليه الأشخاص..
حسب باتريك سيل، بقي شعار “سوريا الأسد” خمسة عشر يوماً على طاولة حافظ الأسد في الثمانينيات قبل أن يقرّه، ويحول سوريا بعدها بالفعل إلى سوريا الأسد التي انتهت بـ أو نحرق البلد..
سوريا اليوم تسير على حدود دقيقة جداً لمسارين متعاكسين ومختلفين بالمطلق، الأول هو حرب أهلية طاحنة وتدخلات إقليمية سافلة وانقسامات طائفية وسياسية وأحقاد سهل جداً إخراجها وإخراج أسوأ ما في السوريين كما رأينا في الأحداث التي مرت في الشهور الماضية.. والثاني هو مسار نجاح اقتصادي وسياسي وسلم أهلي يطلق أفضل ما في السوريين.
الدعم الدولي، ورفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، واحتضان السعودية وقطر وتركيا بشكل أساسي، هو فرصة تاريخية لتعزيز المسار الثاني. ولا ننسى أن ألمانيا مثلاً لم تكن لتبدأ مسارها العظيم بعد الحرب العالمية الثانية لولا مشروع مارشال ودعم دول التحالف وعلى رأسها أمريكا.
أتمنى أن ينجح هذا البلد وأهله في التعافي، والخروج من بئر القذارة الذي حفره أبله موسكو، بعيداً عن المهاترات والاستقطابات وتحديات التوتر العالي التي ملأت العالم الواقعي والافتراضي في الفترة الماضية.
في بداية الألفية، اعتقل النظام معظم رموز الموقعين على إعلان دمشق/بيروت، ثم عاد بعد سنوات ليطبق حرفياً ما كانوا يطالبون به بالعلاقة مع لبنان والاعتراف بسيادته.. اليوم ومع الدعم الدولي والإقليمي، بدأت السلطة بسرعة تصحيح المسار وتطبيق “بعض” ما طالبنا ونطالب به، سواء بمسار إعادة الضباط المنشقين، أو بالمسار “الخفي” للمقاتلين الأجانب، أو بمسألة وضع اللثام على وجوه عناصر الأمن الذي بدأ أمر أزالته ابتداء من اللاذقية، أو بمسار اللامركزية وتوزيع السلطة وهو ما قد يمضي مع تقسيم البلد لخمس مناطق إدارية وتوزيع السلطة فيها بالارتباط مع المركز… أو غير ذلك مسارات كثيرة تحتاج إلى مشاركة الجميع، وحق الجميع بالشعور بأنهم بوطنهم وعلى أرضهم، والمشاركة بإعادة بناءه، فتحرير سوريا هو تحرير للجميع، وسقوطها هو سقوط للجميع دون استثناء.
الفيس بوك
——————————————
=====================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 19 أيار 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
—————————-
ارتدادات مرتقبة في سوريا لحل “العمال الكردستاني”/ خالد الجرعتلي
18 أيار 2025
تباينت القراءات حول تداعيات إعلان “حزب العمال الكردستاني” عن حلّ نفسه وتخليه عن العمل المسلح، خصوصًا تأثيره المباشر في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث يشكّل الحزب تاريخيًا المرجعية الإيديولوجية والعسكرية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وتتقاطع المصالح في المنطقة التي ينتشر فيها “الحزب” والأطراف المتفرعة عنه في سوريا، إذ تضرب تركيا المنطقة منذ سنوات، وتطالب بخروج “العمال” منها، بينما تنتشر قوات عسكرية غربية تحت مظلة التحالف الدولي، داعمة لـ”قسد”، التي يتحكم فيها العمال.
الحزب أعلن عن حل نفسه، وإنهاء حركته المسلحة التي كانت توجه ضد تركيا بشكل أساسي، وتتفرع ضد أطراف أخرى في مناطق، وبلدان أخرى.
وقال الحزب، في 12 من أيار الحالي، في بيان نشرته وسائل إعلام كردية منها شبكة “رووداو” (مقرها أربيل)، وألقاه زعيمه الحالي، جميل بايق، إن “قرار نزع سلاحه وحل نفسه هو من أجل الحل الديمقراطي والسلام الطويل الأمد”.
وعقب إعلان “العمال” حل نفسه، قالت صحيفة “حرييت” التركية، إن أنظار أنقرة تتجه إلى تسليم حزب “العمال” أسلحته، وعلى وجه الخصوص، الصواريخ الموجهة والمعدات الأخرى الموجودة في سوريا.
وأضافت أن حزب “العمال” المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا، وأمريكا، ودول أوروبية، تلقى شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر في سوريا تحت ذريعة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي وقت تتعدد فيه التحليلات حول الملف، يبدو قرار حلّ “العمال الكردستاني”، نقطة تحوّل فارقة في المعادلة السورية، لكنه سيظل مرهونًا بمدى التزام كوادر الحزب بالانسحاب من المشهد، إلى جانب استعداد القوى الكردية والسورية الرسمية على حد سواء للانخراط في تسوية وطنية شاملة، تتجاوز الحسابات الأمنية إلى معالجة القضايا الأمنية والسياسية المتراكمة.
تخفيف الذريعة التركية… ولكن الخلاف أعمق
شكل وجود “العمال” في سوريا ذريعة للتدخل التركي في شمالي سوريا، ورغم أن “قسد” نفت خلال السنوات الماضية، ارتباطها بـ”العمال” ووجود أفراد وقادة منه في المنطقة، اعترف قائدها مظلوم عبدي بوجودهم، لكنه قدم وعودًا بإخراجهم من سوريا في حال الوصول لوقف إطلاق نار مع تركيا.
“الحزب” الكردي الاشتراكي، شكل عوائق أمام تفاهمات “قسد” مع دمشق، إذ رفض خروج أفراده وقادته من المنطقة قبل ضمان أن تحظى “قسد” بمركز قيادي في سوريا، وهو ما سبق أن نقلته وكالة “رويترز” مطلع العام الحالي، مع انطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين.
وعلى ضوء حل “العمال” نفسه، بدت مبررات تركيا للتحرك العسكري، واعتبار أن الشمال السوري مصدر قلق أمني، أقل صدى، لكن خبراء تواصلت معهم عنب بلدي يعتقدون أن الواقع أبعد من ذلك.
ويرى الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أسامة شيخ علي، أن تركيا، التي طالما استخدمت علاقة “قسد” بـ”حزب العمال الكردستاني” كذريعة لتبرير هجماتها، قد تجد في حلّ الحزب فرصة لتخفيف هذا العبء. لكن جوهر الموقف التركي لا يتعلق فقط بوجود صلة تنظيمية مع “العمال”، بل برفضها القاطع لوجود كيان سياسي كردي مستقل في شمال شرقي سوريا، حتى وإن فكّ هذا الكيان ارتباطه مع قنديل.
الباحث قال لعنب بلدي إن أنقرة لا تثق بالقيادات السورية الكردية، وتعتقد أن معظمهم تلقى تأهيله الفكري والعسكري في معسكرات “الحزب” بجبال قنديل، وبالتالي، فإن أي مشروع سياسي كردي سيظل بنظرها تهديدًا للأمن القومي التركي.
وأضاف أن الخيار الأفضل أمام “قسد” يتمثل في الاستمرار بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية، والانخراط ضمن الجيش السوري كجزء من تسوية سياسية داخلية، ما يمنحها هامش حركة أوسع على الساحة السورية ويجنبها الاصطدام مع الأطراف الإقليمية.
انتقال من العمل العسكري إلى السياسي
أحدث التعليقات التركية الرسمية حول حل “العمال الكردستاني” كانت في 15 من أيار الحالي، عندما ذكر المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أوكتورك، أن بلاده ستتابع عن كثب “لخطوات الملموسة” على الأرض بخصوص تسليم سلاح “العمال”.
وأضاف أن القوات المسلحة التركية ستواصل عمليات التمشيط، وتحديد وتدمير الكهوف والأنفاق، والألغام، والمتفجرات في مناطق انتشار “الحزب”، حتى التأكد من أن المنطقة خالية من أي تهديد، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
مدير مركز “رامان للدراسات”، بدر ملا رشيد، لفت إلى أن التوجه العام داخل “العمال الكردستاني” يشير إلى التخلي عن فكرة العمل المسلح والانتقال إلى العمل السياسي، وهو ما يُتوقع أن ينسحب على “قسد” أيضًا، لاسيما في ظل الاتفاق الذي أبرمه مظلوم عبدي مع الحكومة السورية.
ملا رشيد أوضح لعنب بلدي أن هذا التحول لن يترك فراغًا كبيرًا داخل الساحة الكردية السورية، حيث يظل “حزب الاتحاد الديمقراطي” المرتبط إيديولوجيًا بـ”العمال الكردستاني” هو الحزب المهيمن.
ويعتقد الباحث أن موارد الحزب التي كانت تُوجه لقنديل قد تُعاد توجيهها لدعم “الاتحاد الديمقراطي”، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع قاعدته الشعبية وزيادة حضوره السياسي، خاصة في ظل تراجع دور “المجلس الوطني الكردي” الذي يعتبر منافسه التقليدي، وحظي بدعم من أربيل ذات العلاقة الجيدة مع تركيا.
تحديات التنفيذ ومصير كوادر “العمال”
لم تعلّق الحكومة السورية حتى اليوم على قرار حل “العمال” الذي يهيمن على “قسد” السورية، كما لم تطرح أي مؤشر على موقفها من قرار “الحزب”، في وقت اعتبرت فيه “قسد” و”الإدارة الذاتية” أن حل “العمال” هو أمر إيجابي.
وفي وقت تلف الضبابية تفاصيل القضية حول إلقاء السلاح، ومن الجهة التي ستستلمه، والمطلوبين من “الحزب” لتركيا، وغيرها، تبقى الأبعاد الميدانية في مناطق سيطرة “قسد” بسوريا أكثر وطأة، إذ لم يعرف حتى اليوم مصير المقاتلين الأجانب في “قسد” الذين تطالب الحكومة السورية برحيلهم.
بدوره قال الباحث المتخصص في شؤون شمال شرقي سوريا، سامر الأحمد، لعنب بلدي إن التأثير النظري للحل ينبغي أن يكون كبيرًا، نظرًا لأن كوادر الحزب وخاصة الأجنبية منها كانت تتولى إدارة “قسد” أمنيًا وإداريًا.
وتساءل الباحث عن مدى استعداد هذه الكوادر فعلاً للانسحاب أو التخلي عن مكاسبها، محذرًا من إمكانية ظهور تنظيم جديد يحمل اسمًا مختلفًا لكنه يحتفظ بنفس البنية الصلبة والعصبية التنظيمية.
وأضاف الأحمد أن وجود هذه الكوادر، وخصوصًا في ظل تهديداتها لبعض قيادات “قسد” وحتى لمظلوم عبدي، يعيق تنفيذ الاتفاقات الحالية ويضع عراقيل أمام التحول نحو تسوية سياسية، لكنه يرى أن الخطوة جاءت بتفاهم تركي، ما يرجّح أن يكون لها انعكاسات إيجابية إن مارست أنقرة ضغوطًا جادة لحل الإشكال جذريًا، سواء في قنديل أو في سوريا.
ليس الأول
سبق أن أعلن “حزب العمال” عن حل نفسه بعد عام على اعتقال زعيمه على يد المخابرات التركية في مدينة نيروبي بكينيا، عام 1999، لكنه أعاد تشكيل نفسه لاحقًا، واستأنف عملياته ضد الجيش التركي.
وفي عام 2013، انخرط الحزب مجددًا بمحادثات سلام مع تركيا، وعلّق عملياته العسكرية تمهيدًا لعقد مؤتمر ينهي حالة العداء مع أنقرة، لكنه أعاد استئناف نشاطه المناهض لأنقرة عام 2015، بعد أن هاجمت الأخيرة مواقع له بالقرب من الحدود العراقية.
وتطالب تركيا بحل جميع الفصائل العسكرية المتفرعة عن “العمال” في كل من العراق وتركيا وسوريا، وهو ما لم يوضحه بيان الحزب.
ودعت الحكومة التركية مرارًا إلى إنهاء نشاط الحزب في الدول الثلاث، في وقت استمرت فيه محادثات أنقرة مع الحكومة العراقية، التي انتهت بإدراج العراق لـ”العمال” على “لوائح الإرهاب” لديه.
عنب بلدي
————————————
حل حزب العمال وآفاق انفتاح تركيا على كردها/ عبد الباسط سيدا
18 أيار 2025
لا يمكن عزل قرار «حزب العمال الكردستاني» الخاص بحل الحزب، والتخلي عن السلاح بناء على طلب زعيمه عبدالله أوجلان، المعتقل في جزيرة ايمرلي منذ عام 1999، عن سلسلة من التحولات النوعية التي جرت، وتجري، في المنطقة، بدءأً من غزة، ومروراً بلبنان وسوريا واليمن، وربما في دول أخرى قد يكون العراق بينها، وهي تحولات قد ستؤدي إلى معادلات واصطفافات جديدة في إقليمنا.
وفي هذا السياق، يبدو أن الخطوة اللافتة التي أقدم عليها دولت بهتشلي، زعيم «حزب الحركة القومية» المشارك في الائتلاف الحاكم، في البرلمان التركي لم تكن فردية، وذلك حينما توجه بالتحية إلى ممثلي حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المحسوب على حزب العمال، ومن ثم مطالبته بدعوة أوجلان إلى البرلمان ليعلن التخلي عن السلاح وحل حزب العمال، وذلك مقابل منح الأخير حق الأمل. بل كانت على الأغلب بالتوافق مع شريكه في الائتلاف الحاكم، «حزب العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وقد أسفرت تلك الخطوة، وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية، إلى خروج أوجلان على الملأ ليطالب حزبه بترك السلاح وحل نفسه. ومن ثم كانت التصريحات والتسريبات بشأن القرار الذي اتخذه المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال وشارك فيه أوجلان نفسه عن بعد؛ وهو القرار الذي رحبت به الحكومة التركية والأحزاب التركية المعارضة، إلى جانب الأحزاب الكردية في كل من تركيا وإقليم كرستان العراق وسوريا؛ بالإضافة إلى الترحيب الإقليمي، وحتى الدولي، على أمل أن يكون مقدمة لعملية سلمية تقود إلى حل عادل للقضية الكردية في تركيا؛ حل سيكون في صالح تركيا وكردها، وفي صالح تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ورغم وجود علامات استفهام كثيرة حول مدى جدية هذا القرار وآليات تنفيذه، وكيفية التعامل مع التحديات والصعوبات التي ستبرز أثناء عملية التنفيذ، ومنها على سبيل المثال: مصير القيادات المطلوبة تركياً وأمريكياً، بالإضافة إلى حدود تأثير النظام الإيراني في ميدان عرقلة تنفيذ هذا القرار، وذلك من خلال القيادات المقربة منه؛ وغير ذلك ومن المسائل الإجرائية التي قد تكون مثار تباين وخلاف.
ولكن في جميع الأحوال لن يعود حزب العمال بعد هذه الخطوة مستقبلاً ليكون ذاك الحزب القادر على التحكّم بالورقة الكردية في تركيا، ولن يكون في مقدوره التدخل بنفس المستوى في شؤون الكرد سواء في العراق أم في سوريا. ولن يكون في وسعه الاستمرار في الإدعاء بأنه يمثل المخاطب الشرعي والوحيد في أي مسعى يرمي إلى وضع حل للقضية الكردية في تركيا؛ وهي القضية الأقدم والأكبر من حزب العمال وبقية الأحزاب، بل تعود بجذورها الحديثة على الأقل، إلى المراحل الأخيرة للدولة العثمانية التي تصاعد فيها النزوع القومي، وإلى بدايات تأسيس الجمهورية التركية التي التزمت الأيديولوجية القومية التي فرضها مؤسسها مصطفى كمال على الدولة. وكانت الحصيلة جملة نتائج منها اعتماد سياسات التتريك، والقطع مع التراث الإسلامي عبر تطبيق النمط الغربي على مستوى الحياة الشخصية للمواطنين؛ هذا إلى جانب تبني الأبجدية اللاتينية الأمر الذي أحدث قطيعة معرفية ما زالت تركيا تعاني من تأثيراتها السلبية بمختلف الأشكال، هذا رغم الجهود الاستثنائية التي بذلت لاحقاً على صعيد توفير الشروط المطلوبة للعودة إلى المصادر والمراجع العثمانية المكتوبة بالأبجدية العربية.
يشكل الكرد في تركيا حالياً الأغلبية في أكثر من 20 ولاية من أصل 81 ولاية تتشكل منها تركيا. أما على صعيد العدد، فلا توجد إحصائيات رسمية، ولكن التقديرات من جانب الباحثين المتابعين تبين أن عدد الكرد في تركيا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون مواطن كردي يحملون الجنسية التركية. وهذا فحواه أن هذه القضية هي أكبر من أن تُختزل في حزب العمال؛ كما أنها أكبر من أن يتم غض النظر عنها، أو إرجاء البت فيها، أو التصريح بعدم وجودها أصلاً، وعدم التفكير بالعمل من أجل الوصول إلى حل عادل لها، يضع حدا للمعاناة الكردية في تركيا. وهذه المعاناة هي حصيلة عقود من الاضطهاد والإنكار والتجاهل وعدم الاعتراف، مما أدى إلى تراكم سلبيات هائلة في مختلف الميادين، سلبيات ولّدت الحساسيات، وأوجدت الجدران النفسية، ورسخّت الأحكام المسبقة التضليلية، وكل ذلك استفادت منه الحركات والقوى السياسية المتطرفة المتشددة على الضفتين. إلا أن هذا الوضع تحوّل تدريجياً نحو الإيجابية، وكان الاختراق الكبير في عهد رئاسة توركت أوزال (1989-1993) الذي اعترف صراحة بوجود كردي كبير في تركيا، ولم يجد أي خطورة في احترام الثقافة الكردية والاعتراف بحق الكرد في استخدام لغتهم وإحياء ثقافتهم ضمن إطار وحدة الشعب.
ومع أن هذا النَفَس الانفتاحي لم يستمر طويلاً، إلا أنه أسس لامكانية بلورة رؤية جديدة في التعامل مع الموضوع الكردي، وهي الرؤية التي تحولت إلى موقف سياسي لحكومة العدالة والتنمية لاحقاً. هذا رغم الانتكاسات التي حصلت، والصراعات التي كانت بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني الذي عمل بكل طاقاته للهيمنة على الورقة الكردية، وإبعاد بقية الأطراف الكردية عن ساحة التأثير. وقد استفاد في هذا المجال من علاقاته الإقليمية مع سلطة آل الأسد والنظام الإيراني، وأصبح مع الوقت مندمجاً في حسابات السياسات الإيرانية في كل من العراق وسوريا، خاصة في المناطق الكردية.
كما شكل الحزب المعني أداة للضغط على تركيا لصالح أجندات إيرانية، وليس من أجل دفع الأمور نحو الوصول إلى حل سياسي مقبول للقضية الكردية. هذا رغم وجود عوامل مساعدة لمثل هذا التوجه، من بينها أن تركيا دولة قائمة على المؤسسات رغم كل الملاحظات. يقوم نظامها على التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية تحترم نتائجها سائر الأحزاب المتنافسة بغض النظر عن موقعها من الحكم، أو موقفها من الحكومة. وقد قطعت شوطاً لا بأس به على صعيد التعامل الإيجابي مع الموضوع الكردي منذ مجيء حزب العدالة إلى الحكم. وهناك اليوم أقسام للدراسات الكردية في جامعات تركية عديدة لا سيما في الولايات ذات الأغلبية الكردية. وهناك دور نشر ومؤسسات إعلامية كردية، وأحزاب كردية مرخصة. بالإضافة إلى ذلك ليس هناك سقف للمراكز التي يمكن أن يصل إليها المواطنون الكرد في مؤسسات الدولة طالما أنهم يلتزمون بدستور الدولة وقوانينها. وهناك الكثير من المهرجانات الفنية والمناسبات الاحتفالية الكردية التي تنظم إحياء لذكر أعلام الأدب الكردي، وحتى ذكرى بعض السياسيين ورجال الدين الكرد. وكل هذه الخطوات وغيرها تساعد في تهيئة الظروف لعرض وجهة نظر متكاملة حول مقترح حل عادل للقضية الكردية في تركيا تقدمه الحكومة إلى البرلمان، ليُنَاقش من قبل مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، وحتى خارج البرلمان ضمن صفوف الأحزاب والمنظمات والقوى المؤثرة في المجتمع بغض النظر عن الانتماءات والتوجهات، وذلك باعتبار أن هذه القضية هي قضية وطنية عامة تخص الجميع.
ومثل هذه الخطوة لو تحققت، ستفتح الآفاق أمام حل واقعي ممكن مستدام، حل سيكون من دون شك لصالح استقرار وازدهار المجتمع التركي، ويمنح تركيا قوة إضافية تمكّنها من أداء دور كبير منتظر على مستوى المنطقة بمزيد من التأثير والفاعلية، وذلك بعد أن تكون قد تجاوزت «عقلية المشكلة»، التي تتعامل بموجبها مع الموضوع الكردي، لتعتمد «عقلية التواصل». فحل الموضوع الكردي سيمكن تركيا من بناء الجسور المتينة مع كرد المنطقة سواء في سوريا أم في العراق وحتى في إيران؛ الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على صعيد العلاقات مع هذه الدول؛ بل سائر دول الإقليم وحتى على المستوى الدولي، وبالتالي تكون (تركيا) قد استعدت لأداء دور كبير يتناسب مع حجمها وامكانياتها وموقعها وتاريخها.
وبالعودة إلى موضوع حل حزب العمال، يُلاحظ وجود ارتياح عام في الأوساط الكردية والتركية بخصوص هذه الخطوة، لأن وجود هذا الحزب كان يعرقل استمرار العمل السياسي الناضج على المستوى الكردي في تركيا حيث القوانين تسمح بتشكيل الآحزاب، وتقرّ بحقها في النشاط والدعاية، والمشاركة في الانتخابات. فحل الحزب المذكور معناه إزالة العقبة التي كانت تمنع الكرد من ممارسة العمل السياسي بأريحية وحرية، ومثل هذه المشاركة ستضفي المزيد من الشرعية على المطالب الكردية، وستساعد على بناء التحالفات مع الأحزاب التركية المتنافسة؛ وهذا مؤداه استقرار داخلي يمكّن تركيا من تركيز جهودها على قضايا التنمية، وتوفير المقدمات الضرورية لضمان مستقبل أفضل لشبابها وأجيالها المقبلة.
وفي هذا المجال لا بدّ من أخذ التركيز الأمريكي في عهد ترامب الثاني على مكانة تركيا ودورها في الإقليم عموماً، وفي سوريا على وجه التخصيص، بعين الاعتبار؛ وقد شمل هذا الدور السعودي أيضاً، والخليجي بصورة عامة، وهو ما سمعناه كثيراً على لسان ترامب أثناء زيارته الخليجية التي التقى خلالها بالرئيس السوري، وأعلن عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. كما شدد في الوقت ذاته على أهمية عودة أمريكا إلى منطقة الشرق الأوسط بقوة، وذلك لإدراكه بأن أي فراغ سينجم عن الانسحاب الأمريكي سيتم استغلاله بكل تأكيد من قبل المنافسين.
*كاتب وأكاديمي سوري
القدس العربي
———————————
شبكة أنفاق تحفرها “قسد” تهدد بانهيار المباني في الرقة/ عبد الله البشر
19 مايو 2025
يعيش سكان مدينة الرقة مخاوف مستمرة من حدوث انهيارات أرضية تطاول مباني سكنية، نتيجة توسع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في حفر الأنفاق
انهار طريق في شارع الوادي بمدينة الرقة، عقب مرور قاطرة ثقيلة، في 26 مارس/ آذار الماضي، ليكتشف الأهالي وجود نفق في المنطقة حفرته “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وقوبل الأمر بنداءات من الأهالي لإيقاف حفر الأنفاق، لكنها لم تلقَ أي استجابة.
من الرقة، يقول سلامة الفيصل لـ”العربي الجديد” إنّ “الكثير من الأنفاق حُفرت تحت المدينة، ومشروع الحفر هو مخطط وممنهج، لكنه يهدد المنازل والبنية التحتية في المدينة، وتتجاهل (قسد) تحذيرات ونداءات السكان التي تطالب بإيقاف عمليات الحفر”. يضيف الفيصل: “وفق معلومات الأهالي، هناك مرافق كاملة تحت الأرض يشرف عليها شخص يدعى إسماعيل الأحمد الإسماعيل، وهو يقود مع شقيقه إبراهيم مجموعة من عمال حفر الأنفاق. الخطر يكمن في تشعب الأنفاق وكثرتها، ولا نعلم بالتحديد لماذا يتم حفرها، لكن ما يخيفنا هو احتمالية تحويل بعضها إلى مستودعات لتخزين الأسلحة. تروج (الإدارة الذاتية) لمشاريع خدمية في الرقة، لكن حفر الأنفاق لا يمت بصلة إلى مشاريع الخدمات، وهو تهديد للبنية التحتية، ويعرض حياة السكان للخطر، ونحمّلهم مسؤولية النتائج الوخيمة على المدينة وسكانها”.
وكشفت مصادر محلية في الرقة عن وجود شبكة متشعبة من الأنفاق أسفل المدينة، بما في ذلك منطقة “وادي الفرات”، وهي منطقة ذات تربة غير مستقرة تجعلها عرضة للانهيار، وسجلت الرقة أخيراً انهياراً أرضياً بالقرب من “جامع الجراكسة”، ما يعكس خطر عمليات الحفر على المباني. ويؤكد النازح من مدينة الرقة، محمد العثمان لـ”العربي الجديد”، أن الأنفاق تضم سجناً سرياً يقع أسفل المنطقة التي تضم مبنى الرقابة والتفتيش جنوبي مركز المدينة، وأن هذا السجن يُحتجز فيه مدنيون.
عنصر من قوات الأمن العام السوري، حلب 12 فبراير 2025 (أسعد الأسعد/فرانس برس)
وأفادت وسائل إعلام محلية، في إبريل/ نيسان الماضي، بأن مدينة الرقة شهدت خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان تسجيل عشرات نقاط الحفر، والتي شملت مناطق حيوية مثل دوار النعيم، والبانوراما، والمشفى الوطني، ومعسكر الطلائع، وجسر الصوامع، ومطحنة الرشيد، وأن عمليات الحفر امتدت إلى داخل الأحياء المكتظة بالسكان مثل الفردوس والجميلي، حيث يُخشى من انهيارات أرضية كارثية نظراً إلى اقتراب الأنفاق من سطح الأرض وعدم استقرار التربة.
ووفق المصادر المحلية، فقد أنشأت “قسد” سبعة أنفاق على طول خط سكة القطار في منطقة جسر الرومانية، إلى جانب ثلاثة أنفاق غرب المنطقة، ونفق في محيط الملعب الأسود، ونفقين قرب حديقة جواد أنزور، إضافة إلى ثلاثة أنفاق أخرى في شارع الجميلي، وثلاثة أنفاق إضافية في منطقة الصوامع، فضلًا عن نشاطات حفر قرب المشفى الوطني.
ومن الرقة، يوضح فارس ذخيرة لـ”العربي الجديد”، أن “فكرة حفر الأنفاق في أحياء مركز المدينة تعود إلى حقبة سيطرة تنظيم (داعش)، والذي عمل على إنشاء شبكة معقدة من الأنفاق، وهذه الأنفاق كانت مصدر خوف كبير لسكان المدينة. على منوال التنظيم الإرهابي، تقوم آليات وعمال تابعون لقوات قسد بحفريات في مراكز حيوية وأحياء، وقد رصدنا العديد منها، ما يشكل خطراً كبيراً على الأبنية والشوارع”. ويثير حفر الأنفاق مخاوف السكان العاجزين عن إيقافها، خاصة أن عمليات الحفر أصبحت علنية. يقول الخمسيني عمر الحاج لـ”العربي الجديد”، إن “الوضع الراهن مقلق للغاية، فالرقة مدينة تضم أعداداً كبيرة من السكان، وهي في حاجة إلى الكثير من الخدمات، منها ما يتعلق بالصرف الصحي والمياه وغيرها. لا نعلم ما ضرورة هذه الأنفاق، لماذا يثيرون مخاوفنا بها، وقد شهدنا مؤخراً انهيارات أرضية بسبب مرور الشاحنات على الطرق، ونخشى أن يتطور الأمر وتنهار بعض المنازل، وما يجري هو استهتار بأرواح الناس”.
يضيف الحاج: “حفر الأنفاق لم يعد خافياً على أحد، فهناك عمال يحفرون في النهار ضمن مناطق مسوّرة باستخدام شبك من الحديد، ويستخدمون رافعات كهربائية لاستخراج التراب من الأنفاق، ولا نعرف كيف ستبرر بلدية الرقة هذا العمل، وهم في الأصل لن يتحدثوا عن المخاطر مع ادعائهم دائماً أنهم يعملون لصالح سكان المدينة”.
وتؤكد حملة “الرقة تذبح بصمت” المحلية، أن قوات “قسد” تواصل عمليات حفر أنفاق تستخدم لأغراض عسكرية، وآخرها حفر نفق في حي الجميلي بوسط المدينة، ضمن منطقة تضررت مبانيها بشدة خلال فترة الحرب على تنظيم “داعش” في عام 2017، ما يزيد احتمالات انهيار المباني في المنطقة مع استمرار عمليات الحفر.
العربي الجديد
——————————-
سورية من إرث الاستبداد إلى بناء الدولة الجديدة/ فيصل يوسف
19 مايو 2025
في ظلّ سنوات طويلة من الصراع والدمار، ومعاناة يومية أثقلت كاهل السوريين، يبرز قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بصيصَ أمل في نفق طويل من الظلمة، لما يحمله من دلالاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قد تُفضي إلى بداية مسار جديد نحو انفراج تدريجي للأزمة، وتوفير أرضية أكثر ملاءمةً لعملية سياسية شاملة ومستدامة، تعالج ما خلّفه النظام البائد من دمار ومعاناة وشرخ عميق في بنية المجتمع والدولة.
تكشف نظرة فاحصة إلى التجربة السابقة أن الإجراءات الاقتصادية، التي غالباً ما يجري تقديمها في سياق “الأدوات غير العسكرية”، قد أثبتت محدوديةَ فعّاليتها في تحقيق الأهداف المُعلَنة، بل إنها، في الواقع، لامست بشكلٍ مباشر حياة المواطنين السوريين، وأثّرت في قدرتهم على تأمين ضرورات الحياة الأساسية. لقد تحوّلت هذه الإجراءات، في أحيانٍ كثيرة، إلى عوامل مساعدة في تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي، وتفسير قصور الخدمات العامّة، وتفاقم مشكلة الفقر والنزوح على نطاق واسع. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار القرار الأميركي المعلن أخيراً بمثابة قراءة جديدة للواقع، نحو تبنّي استراتيجيات أكثر واقعية وتركيزاً في البعد الإنساني، وتشجّع على تفاعل بنّاء وتدريجي مع أيّ سلطة تنفيذية تلتزم مساراً انتقالياً حقيقياً.
إن الآثار الإيجابية المحتملة لتخفيف العقوبات تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، لتشمل إمكانية إيجاد مناخ أكثر إيجابية لتعزيز الثقة وفتح قنوات للحوار. ومع ذلك، يظلّ تحقيق هذه الإمكانات مرهوناً بمدى قدرة المؤسّسات السورية، حكوميةً ومجتمعيةً، على إدارة الموارد بشفافية وعدالة، وضمان وصولها إلى مستحقّيها بعيداً من مظاهر الفساد والاستئثار. كما يستلزم ذلك تضافر الجهود بين الأطراف المحلّية والإقليمية والدولية لدعم الاستقرار الشامل وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، التي تمسّ حياة المواطنين بشكل ملموس.
وعلى صعيد السياق السياسي الأوسع، يكتسب تخفيف العقوبات دلالاتٍ إضافيةً، إذ يتزامن مع حراك دبلوماسي إقليمي ودولي متزايد بشأن مستقبل سورية. يمكن النظر إلى هذه الخطوة حافزاً غير مباشر إلى دفع العملية السياسية، وفقاً لجوهر قرار مجلس الأمن 2254، الذي يشدّد على أهمية بناء نظام حكم ديمقراطي تعدّدي يضمن كل حقوق السوريين، وتنوّعهم، ويضع حدّاً لممارسات الاستبداد والإقصاء التي عانتها البلاد عقوداً.
تفرض المرحلة المقبلة مسؤوليةً مضاعفةً على عاتق الحكومة السورية، والقوى الوطنية الفاعلة كافّة، تستدعي التعامل مع هذه اللحظة المفصلية بروح من الجدّية والمسؤولية الوطنية. يتطلّب ذلك ترجمةَ النيات الحسنة خطواتٍ عمليةً ملموسةً على صعيد إطلاق إصلاحات هيكلية حقيقية في منظومة الحكم، وإظهار التزام راسخ بسيادة القانون ومكافحة الفساد بأشكاله كلّها، وتوسيع فضاء الحرّيات العامّة، وضمان مشاركة سياسية فاعلة لكل ألوان الطيف السوري. لم تعد تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مجرّد مسألة خدماتية، بل أصبحت مكوّناً أساسياً في عملية استعادة الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وخطوةً ضروريةً نحو تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
في صميم أيّ تصوّر لمستقبل سورية، تبرز القضية الكردية اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة والمجتمع على استيعاب التنوّع وتحقيق العدالة، فالشعب الكردي، الذي يمتلك جذوراً عميقةً في هذه الأرض، وإسهامات تاريخية في بنائها، ظلّ يعاني سياسات التهميش وإنكار الهُويَّة والحقوق المشروعة عقوداً. لا يمكن أيّ مشروع وطني شامل ومستدام أن يكتمل من دون معالجة هذه القضية بشكل عادل وجذري، من خلال تضمين الحقوق الثقافية والسياسية للكرد في الدستور السوري، وضمان مشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، بما يعكس انتماءهم الوطني الأصيل وشراكتهم الكاملة في بناء سورية الغد.
إننا نرى اليوم ملامح إجماع وطني متزايد حول الرؤية المستقبلية لسورية، دولةً مدنيةً ديمقراطيةً لا مركزيةً، تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والمساءلة، وتقوم على شراكة وطنية حقيقية ومتكافئة بين جميع مكوّناتها. وفي هذا الإطار، فإن أبناء سورية يتطلّعون، إلى مبادرات بنّاءة من الأشقاء والأصدقاء، تسهم في تعزيز هذا التوجّه، عبر تمكين الشعب السوري من بناء دولته الجديدة على أسس راسخة من الوحدة الوطنية، والتنوّع، الثقافي والقومي والديني.
تكتسب الجهود المبذولة لتوحيد الموقف الكردي وتشكيل وفد موحّد أهمية قصوى، ليس ضرورة لتمثيل مصالح المكوّن الكردي فقط، بل إسهامٌ حيوي في تعزيز الوحدة الوطنية، لأن وجود صوتٍ كرديٍّ موحّد في أيّ حوارات سياسية مقبلة يُعزّز من قوة هذا المكون وقدرته على الدفاع عن حقوقه المشروعة، ويمثّل، في الوقت نفسه، إضافةً نوعيةً إلى الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء نظام ديمقراطي تعدّدي، يضمن المواطنة المتساوية، ويؤسّس لحكم رشيد يشارك فيه الجميع في صنع القرار وتحديد المصير المشترك.
تأكيد وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية قاسم مشترك يجمع عليه جميع السوريين، إلا أن هذا المفهوم لا ينبغي أن يُختزَل في إطار المركزية الصارمة، التي أثبتت التجارب أنها كانت بيئةً حاضنةً للفساد والتهميش والإقصاء. يمثّل تبنّي نظام ديمقراطي لا مركزي ضمانةً حقيقيةً لتوزيع عادل للسلطة والموارد، وتمكين المجتمعات المحلّية من إدارة شؤونها بكفاءة وفعّالية ضمن إطار الوحدة الوطنية، بما يُعزّز الانتماء الوطني، ويُحقّق التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد. تصوير هذا الخيار دعوةً إلى التقسيم ينبع من فهم ضيّق لطبيعة الدولة الحديثة، التي تستمدّ قوّتها من قدرتها على احتواء تنوّعها، وتقدير اختلافات مكوّناتها، وبناء شرعيتها على أساس من رضا مواطنيها وثقتهم بمؤسّساتها.
ختاماً، يتطلّب استثمار هذه اللحظة التي تحمل في طياتها بوادر انفتاح سياسي واقتصادي تبنّي رؤية وطنية متكاملة وشاملة لبناء سورية المستقبل. رؤية تنطلق من الاعتراف بالحقائق الراهنة، وتؤمن بالشراكة السياسية والاجتماعية الحقيقية، وتتبنّى إصلاحاتٍ جوهريةً تمسّ جوهر المشكلات، وتضع المواطن السوري، بكلّ مكوناته وتطلعاته، في صلب أيّ مشروع وطني. لقد آن الأوان لتجاوز حقبة الاستبداد والانقسام، والانطلاق نحو بناء عقد اجتماعي جديد، يفتح الباب أمام مستقبل تزدهر فيه سورية بتنوعها ووحدة أبنائها.
العربي الجديد
———————————–
دمشق مرة ثانية/ بشير البكر
الإثنين 2025/05/19
زرت دمشق في شباط الماضي بعد غياب 45 عاماً. وحينما غادرتها بعد حوالي أسبوعين، قلت بيني وبين نفسي، إن هذه الزيارة غير محسوبة. لم يكن الوقت كافياً لرؤية الأهل والأصدقاء والزملاء، والقيام بجولات في المدينة من أجل الكتابة. أغلب الذين التقيت بهم عتبوا عليّ لأني غادرت ولم أمكث مدة أطول. وكان لديهم الحق في ذلك. كان يجب أن أكرس وقتاً أطول لتلك الزيارة، وألا تقتصر على دمشق لوحدها. ثمة من دعاني لزيارة السويداء ودرعا وحلب وحمص وحماة واللاذقية، وخاطبني كثيرون من أفراد عائلتي وأقربائي، وألحوا على ضرورة زيارة مدينتي الحسكة، التي تعيش وضعاً صعباً يفوق ما تواجهه المدن السورية الأخرى.
لم يكن لدي من الوقت أكثر من أسبوعين، وكان عليّ أن أرجع إلى باريس بسبب ارتباطي بمواعيد تحددت قبل سقوط النظام، وما كان في مقدوري تأجيلها. ثم أن زيارة دمشق في ذلك الوقت كانت على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلي، لأني اردت التعرف من كثب على الإدارة الجديدة، التي تربطني صداقات ببعض سياسييها وإعلاميها. حاولت أن أجد أجوبة للكثير من الأسئلة التي بقيت تشغلني مثل غالبية السوريين، الذين يأملون أن تستقر سوريا، وتباشر ورشة عمل لتنظيف البلد، ووضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية على أسس تشاركية، وتحقيق العدالة للمتضررين من عهد آل الأسد، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها نظاما الأسد الأب والابن.
زيارة المدن السورية الأخرى أمر لا يقلّ إلحاحاً عن دمشق، التي تشكل نقطة البداية في الوطن سياسياً ووجدانياً. فإذا لم تكن دمشق مستقرة وعلى عافية، لن يستقيم الوضع في بقية أنحاء البلد. وهذا أمر شهدناه طيلة أعوام الثورة، حينما تمكن النظام العام 2015 من استعادة المبادرة بمساعدة روسيا. وبعدما كان على وشك السقوط، قام على قدميه سياسياً وعسكرياً. ولعبت روسيا وإيران ورقة السيطرة على العاصمة من أجل تثبيت بشار الأسد، وإعادة تأهيله محلياً وعربياً ودولياً.
زيارة مدينة الحسكة، لا تقارن بأي زيارة أخرى، كونها المدينة حيث وُلدت، وعشت فيها طفولتي وشبابي الأول، وما زال القسم الأكبر من عائلتي يقيم فيها، وفوق ذلك لها خصوصية سياسية مهمة، لأنها ليست محكومة من الدولة السورية، بل من “قوات سوريا الديموقراطية” التابعة للإدارة الذاتية الكردية، والتي تفرض على أي زائر إلى هناك إجراءات، لا أقبلها من طرفي، لأنها تمس مبدأ سورية هذه المنطقة، وتطعن في أنها جزء من الدولة السورية. وينتظر أهل المدينة من أبنائها المثقفين والإعلاميين والسياسيين أن يعرضوا قضيتها أمام الرأي العام السوري، عسى أن تبادر السلطات لإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعانيها، لا سيما المياه، عصب الحياة للاستهلاك والزراعة التي تأثرت بسبب تراجع المطر. وتعد حصيلة هذه السنة كارثية، إلى حد أنه يتوجب إعلانها منطقة منكوبة.
لا أحس بأن زيارتي الثانية التي بدأت قبل أيام ستحقق كل ما أصبو إليه، والقسط الأكبر منه عاطفي ووجداني، وأظن أن ذلك لن يتحقق كلياً، حتى لو أقمت هنا بصورة نهائية، وهذا سيحدث حتماً ذات يوم. ذلك أن غياب 45 عاماً ليس بالأمر العادي الذي يمكن للمرء أن يمر عليه بسهولة. أحتاج إلى وقت كي أعوض ما فاتني هنا، وإلى جهد كبير حتى أسدد لبلدي ما له في ذمتي من ديون، والقيام بما يترتب عليّ من مسؤوليات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من جميع السوريين التكاتف من أجل النهوض بسوريا التي نحبها، ونطمح لأن ترجع أرض لقاء وثقافة وقلب المشرق العربي وحاضنة قضاياه، خصوصاً قضية فلسطين.
أحس اليوم بفاصل زمني كبير مر بين الزيارتين، رغم أن الوقت لم يتجاوز الشهرين ونصف الشهر. ربما يرجع السبب إلى أن كثير من التطورات، الأمر الذي يبعث على الإحساس بأن المدة التي استغرقتها طويلة، أو ربما هو مجرد إحساس تشكل لدي لكثرة ما استغرقت من تفكير في كل تفصيل سوري، وهذا شأن لا يقتصر على فئة دون غيرها من السوريين، بل تتشاركه الغالبية العظمى، خصوصاً أبناء البلد الذين غادروا بعد العام 2011، ولم تتسنّ لهم زيارته بعد سقوط النظام، وذلك لأسباب تتعلق بقوانين اللجوء، التي تسمح للاجئ بزيارة كل العالم، باستثناء البلد الذي جاء منه.
دمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، تختلف كلياً. ذلك ما تقوله عيون السوريين التي تبرق بالأمل في أن تبدأ البلاد مرحلة التعافي، وتباشر ردم المسافات بين أبنائها ومكوناتها، لترجع سوريا إلى لونها الزاهي المتعدد والمتنوع.
المدن
———————————
=====================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 19 ايار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
———————————–
لا تسلّموا سورية إلى إسرائيل/ لميس أندوني
18 مايو 2025
ليس عنوان المقال موجّهاً إلى الشعب السوري، وأيضاً ليس بالضرورة إلى الإدارة السورية، وإنما هو للتحذير من التخلي عن سورية وتركها رهينة الشروط الأميركية لرفع الحصار الخانق عنها، هذا من ناحية. والتهديدات الإسرائيلية التي قد لا تنسحب من الأراضي التي توغلت فيها، وتمارس الابتزاز لتقسيم سورية وتفتيتها، أو على الأقل إنهاكها أكثر مما هي عليه. العنوان رسالة إلى الدول العربية القادرة على حماية سورية، ليس بشنّ حربٍ نيابة عنها، وهو أصلاً أمر غير مطروح، وإنما بدعم اقتصادها والوقوف معها سياسياً وإنسانياً.
الخوف أن بعض الدول لن تفعل ذلك، بل تضغط على سورية لدخول الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل، وكأن هضبة الجولان غير محتلة، وكأن إسرائيل لا تسيطر على أراضٍ سورية وتقصفها حينما تشاء، دمّرت الجيش السوري منذ أول أيام سقوط النظام السابق، في خطوة مقصودة، فسورية لم تكن لتشنّ حرباً على إسرائيل، لأنها تحتاج إلى استعادة جزء من عافيتها، فالوضع يحتاج إلى الهدوء والاستقرار لإعادة بناء بلد دمّره نظام دموي، وعانى شعبه سنوات طويلة من الغُبن والاستبداد.
لا يمكننا إلا مشاركة الشعب السوري فرحته بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه بوقف العقوبات القاسية، التي لم تطاول النظام السابق في تأثيرها، بل الدولة والشعب السوريين.
بغض النظر عن أي رأي أو موقف من ترامب، فشعور التحرّر من قبضة المقاطعة لا يمكن التقليل منه، ومن يريد أن لا يحس أو يفهم لأسباب أيدولوجية مسبقة فهذه مشكلته، وفي رأيي الموضوع هو موقف أخلاقي قبل كل الاعتبارات والحسابات.
لكن انعدام الثقة في أميركا ليس عبارة عن وهم أو انطلاقاً من نظريات المؤامرة؛ فهذه ليست المرّة الأولى ولا الأخيرة التي تخذل أميركا أو تخون شعوباً اطمأنت إلى وعودها، وغزّة شاهدة على ذلك، فقد نام أهلها على وقف إطلاق النار كان وراءه ترامب، وأفاقوا عند الفجر على نار القصف تلتهمهم في أيام عيد الفطر، ونأمل أن نكون مخطئين بشكوكنا ومحاذيرنا، لكن تجربة الشعوب مع أميركا وإسرائيل مريرة.
للحق؛ لا يمكن لوم الشعب السوري إذا تعلق بأي قشّة للخلاص، ولا يحقّ لأحد المزاودة، فالعلّة الأساس أن أي دولة أو شعب يقع لا يجد أملاً في نظام عربي مهترئ، لأن الكل وضع الحلّ في يد أميركا التي لديها مصالحها، فنحن منطقة نفوذ، ولست متأكدة أن كل بوادر النية الحسنة العربية، بما فيها مشاركة دول عربية في استثمارات هائلة لإنعاش الاقتصاد الأميركي، كافية لتغيير أي شقٍّ من الاستراتيجية الأميركية، وإلا لوضع ترامب كل ثقله لوقف حمّام الدم الذي تدفق بكثافة خلال جولته في المنطقة، فما يريده لا يجعله يستعجل بإنقاذ أرواح الفلسطينيين بل يعمل على مهله.
خلاف ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنْ كان حقيقياً، ليس كافياً ليعاقب إسرائيل أو أيضاً يهدّد بوقف تزويدها بالأسلحة أو المساعدات، ولا يجعله يأخذ موقفاً علنياً من التوغل الإسرائيلي في سورية، بل ما صرح به من ضرورة التخلص من السلاح الفلسطيني في غزّة، فلديه مصلحة في السيطرة على القطاع المنكوب من حرب الإبادة الصهيونية، ومن دعوته الرئيس السوري أحمد الشرع للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية التي كانت الإمارات أول من وقع عليها عام 2021، بدون أن يذكر، حتى من قبيل الإشارات، الاعتداءات المتكرّرة على الأرض، إذ إنها تزيد من الضغوط على سورية للمصالحة مع إسرائيل بدون المطالبة بحقوقها واستعادة السيادة على أراضيها.
التطبيع مع دولة لديها مشروع استيطاني إحلالي وتنفذه، إضافة إلى أنه يزيد من إمعانها في إبادة الشعب الفلسطيني، فهو لا يضمن الأمان لأي دولة عربية خاصة التي تأذت من احتلال إسرائيل لأراضيها وتقع في المنطقة الجغرافية المحاذية لإسرائيل. وليس أن الامارات والبحرين في منأى من أطماع إسرائيل، فهي ترى في الدولتين مصدر نهبٍ لأموال ونفط لا يُشبِع شراهتها إلى الهيمنة والتحكّم، لكن الخطر أكثر مباشَرة على لبنان والأردن ومصر وسورية، فالمشروع الصهيوني يتطلب احتلال أراضٍ في كل من الأردن ولبنان وفلسطين، بحجّة توفير الأمن لإسرائيل، والتحكم في شروط علاقاتها وتحالفاتها بل عقيدة جيوشها، لقد أصبح الأمر ليس مجرد كلماتٍ في كتبٍ صهيونية، بل تحس أنها تستطيع تنفيذ ذلك، من خلال الاعتداء المباشر ومن خلال توقيع اتفاقيات مجحفة بحق سيادة هذا الدول وثرواتها، فكما نرى في لبنان والأردن، تتصرف إسرائيل وكأن الغاز اللبناني والثروات الطبيعية في الأردن والمياه، على شح توافرها، حقّ لها. وللتذكير، أو لتنبيه من لا يعرف، حوّلت إسرائيل، بل سرقت، حصة الأردن من مياه بحيرة طبريا في الستينيات، وفرضت على الأردن تقاسم موارده المائية، بالرغم من التوصل إلى معاهدة وادي عربة “للسلام” عام 1994.
أنا في حيرة؛ إذ ما زلنا نجد أن علينا التحذير من أخطار إسرائيل بعد مرور 77 عاماً على النكبة الفلسطينية، وبالرغم من فداحة المجازر اليومية التي لا تأبه إسرائيل بارتكابها أمام عدسات التصوير وتبثّ على الشاشات في العالم، فإذا كان هناك شك أن الخطر الإسرائيلي يهدد الفلسطينيين فقط فهذه مشكلة كبيرة، والمصيبة إذا كانت حرب الإبادة بتفاصيلها المرعبة لا تقنع أي عربي بجرم إسرائيل، فلا شي يقنعه إلا إذا وصل إليه الخطر ويكون الوقت متأخّراً… كتبت هذه الجملة وأنا في ذهول من أن قد نكون قد وصلنا إلى مرحلةٍ من عدم الاهتمام بالنكبة الفلسطينية، فالأصوات المطالبة والمؤيدة للتطبيع تعلو أكثر من أي وقت مضى في زمنٍ يسود فيه وهم الخلاص الفردي، أو في خلاص كل دولة عربية على حدة، فالحرب على الشعب الفلسطيني بدأت قبل ظهور حركتي حماس وفتح، بل كان ظهورهما نتيجة مشروع اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، وليس العكس، فمن يرى من الدول القادرة على دعم دولة عربية وحمايتها من الانجرار إلى فخ المعاهدات الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك تساهم بالضغط لإغراق العرب في المستنقع الإسرائيلي، لا تهتم وتحسّ بمعاناة الشعب الفلسطيني أو السوريين، وإنما ترى المشهد من زاوية عقد صفقات أمنية أو مالية لا أكثر.
أسوق المقال، من منطلق الحرص، وأوجّه رسالة إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن لا يقبل التوقيع، لأن ذلك قراره في نهاية الأمر، لكن الأهم التوجّه إلى الدول التي تستطيع أن تلعب دوراً حاسماً في حماية سورية، فيكفينا النكبة الفلسطينية، ولا يستحق الشعب السوري إلا إنهاء عذابه وولوج فجر حريته وازدهاره، فالشعب الفلسطيني ليس أهم الشعوب، لكن تجربته هي، للأسف، درسٌ عن معنى ومأساة استهداف المشروع الصهيوني، الذي لا يؤمن بالتعايش مع الشعوب بل بالهيمنة عليها.
العربي الجديد
————————————
إسرائيل أرادت استمرار العقوبات على سوريا/ محمود سمير الرنتيسي
2025.05.18
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا كان رفع العقوبات عن الدولة السورية والشعب السوري الذي يتطلع لمرحلة جديدة من الحرية والتعافي أمرا منطقيا واستحقاقا متوقعا، وبالفعل كانت معظم الأطراف الإقليمية والشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسها الشعب السوري تنتظر هذه النتيجة المنطقية، في المقابل كانت هناك جهة تعمل على إقناع الأميركيين بعدم رفع العقوبات عن سوريا وهي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
لقد كان استقبال خبر رفع العقوبات عن سوريا في دولة الاحتلال الإسرائيلي مختلفا عن استقباله في سوريا وفي بقية البلدان العربية والإسلامية حيث أزعج هذا الخبر حكومة الاحتلال وعلى رأسها نتنياهو لأنه بالفعل كما ذكرت التقارير مؤخرا كان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي طلب من ترامب حتى وقت قريب عدم رفع العقوبات عن سوريا، وقد استغل نتنياهو لقاءه الأخير مع ترامب في واشنطن الشهر الماضي لتكرار هذا الطلب.
لم تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي أن طلب نتنياهو وقد قالت القناة 12 العبرية أنهم في إسرائيل لا ينكرون أن نتنياهو طلب الابقاء على العقوبات على سوريا وعدم دعم الاستقرار في سوريا وتم رفض الطلب.
من الواضح أن ترامب كان له رأي آخر وهو ما يشير إلى وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في التأثير في موازين القوى بعد 7 أكتوبر. وإضافة لما سبق لم تكن إسرائيل على علم مسبق بقرار ترامب عقد الاجتماع مع الرئيس السوري في الرياض ولا بقرار ترامب رفع العقوبات، ويأتي هذا في سياق عدم علم إسرائيل باتفاق ترامب مع الحوثيين وكذلك ببدء المفاوضات مع إيران حول المشروع النووي الذي أعلن عنه ترامب في مؤتمر صحافي مع نتنياهو.
وقد قال الكاتب الصهيوني تامير هايمن نحن لسنا في الملعب بل نشاهد الدوري بانتظار انتهاء اللعبة ونلعب على الإسفلت الساخن لعبة عنيفة ومحلية ستنتهي بإصابات تلحق الجميع.
ولكن رغم كل هذا وبالنظر إلى ما يجري في غزة فإن نتنياهو يتعامل على أنه يمكن أن يسير على سياسة خاصة به حتى لو كانت نظرة ترامب مختلفة، ولهذا قام الجيش الإسرائيلي بالقصف قرب القصر الرئاسي في دمشق قبل أسبوعين من أجل تهيئة المجال للسيناريو الذي يريده في سوريا وهو سيناريو عدم الاستقرار. وقد أصدر نتنياهو ووزير الدفاع كاتس بيانا مشتركا قالا فيه “أن إسرائيل هاجمت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق وهذه رسالة واضحة للنظام السوري”. وفي تحد صارخ قال البيان أن إسرائيل لن تسمح بانتشار قوات جنوب دمشق أو أي تهديد للطائفة الدرزية.
وتزعم إسرائيل أن سياستها تجاه سوريا تأتي في إطار سياسة الردع لمنع تكون ما تصفه بأنه “التموضع العسكري المهدد”، وفي الحقيقة تريد إسرائيل نشر الفوضى والتهيئة لمزيد من عدم الاستقرار ليكون بمتناولها العبث والتصرف كيفما تشاء لأنها تعتقد في الحقيقة أن أي استقرار حقيقي في سوريا أو دول الجوار الأخرى لن يكون في مصلحتها.
لا يزال نتنياهو يحلم بتغيير الشرق الأوسط ولكنه لم ينجح في إثارة النعرات عبر دعم بعض الأقليات لنشر الفوضى في سوريا كما أنه من الواضح لم ينجح في إعاقة مسار رفع العقوبات عن سوريا وهذا يؤكد مرة أخرى أن قوة دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد كما كانت من قبل كما أن قدرتها على التأثير في الولايات المتحدة أيضا لم تعد كما كانت من قبل.
ولذلك فإن ما سبق يشدد على ضرورة التصرف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها طرف يريد تعطيل مسارات الاستقرار في كل المنطقة، ويشدد على التعامل معها من منظور أنها دولة وكيان يسير نحو مزيد من التراجع والتدهور.
————————-
السويداء تغادر عزلتها مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا/ أيمن الشوفي
17/5/2025
السويداء- تُبدي السويداء ارتياحا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ولا سيما بعد المرونة التي شهدتها علاقتها مع الحكومة السورية بدمشق، مع آمال أبناء الطائفة الدرزية بمقدرة الإدارة السياسية الحالية للبلاد على إعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية اقتصاديا وسياسيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر خلال زيارته الأخيرة للسعودية قبل أيام، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها “ضرورية” لمنح الإدارة السورية فرصة حقيقية تتيح لها النهوض بالبلاد.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ يوسف جربوع، إن رفع تلك العقوبات أدى إلى تغيير المزاج العام لدى أبناء المحافظة، كما أفشل الرهانات السياسية السابقة، بما فيها رهان التيار السياسي الذي كان يسعى إلى إضعاف السلطة السوريّة، أو عدم الاعتراف بها.
وفي حديث للجزيرة نت، قال جربوع “أعتقد أن الأمور في السويداء تسير باتجاه أفضل، بما في ذلك تعميق العلاقة مع السلطة المركزية، حيث تراجعت الأصوات التي كانت تطالب بالحماية الدولية للدروز في جنوب البلاد على أثر رفع العقوبات الأميركية، وعاد المجتمع المحلي إلى وعيه السياسي المعهود الذي لا يُجيز سوى الارتباط بدولتنا السورية، ومجتمعنا السوري الكبير”.
وكان الرئيس الروحي لدروز فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قد دعا، في بيان له، دروز سوريا إلى أخذ مكانتهم المستحقّة في الوطن السوري الموحد.
وجاء كلام الشيخ طريف سابقا لإعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في محاولة لرفض أي تدخل خارجي بشأن دروز السويداء، حسب مراقبين.
مزاج متفائل
يقول نجيب أبو فخر، رئيس “المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا” (تشكيل درزي)، إن المزاج العام في السويداء، أسوة بما هو عليه الحال في سوريا، سعيد جدا برفع العقوبات عن البلاد، ومتفائل أيضا بأن مستقبل سوريا سيكون أفضل.
وأضاف أبو فخر للجزيرة نت، إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعكس الموقف الدولي الجديد من الإدارة السورية الحالية، مما سيؤدي إلى إنهاء التوترات المحلية، وسدّ الطرق بوجه الفتن والمشاريع غير الوطنية التي كانت تلاقي قبولا واستساغة لدى البعض.
ورأى أن رفع العقوبات كان نتاج جهد “مكثف وذكي” من الدولة السورية، وخصوصا من الرئيس أحمد الشرع والفريق الدبلوماسي “الذي واجه اختبارا معقدا نظرا للظروف الإقليمية، والضغوطات المتعددة داخليا وخارجيا”.
وقال أبو فخر “ربما عكس لقاء الرئيس الشرع بترامب، وطريقة المصافحة والجلوس جميعُها الأنفة التي اشتاق السوريون لرؤيتها على مسؤول سوري أمام مسؤول غربي أو عربي، وهذا ما كان ملفتا للغاية”.
وحسب المسؤول، فإن مشاريع الانفصال لم يعد صوتها عاليا كما في السابق، “بالرغم من أنها لم تختفِ كليا” من المشهد السياسي. ويعتقد بأنه إن تحمّل السوريون مسؤولية خطابهم، وأبعدوه عن الإقصاء والتجييش الديني والمذهبي والمناطقي، “فسنكون حينها على أعتاب نهاية طرح مشاريع الانفصال وتغييبها عن المشهد السوري برمته”.
خطاب الهجري
في هذه الأثناء، جاء لافتا بعض المرونة والتبدّل الذي اكتسبهُ خطاب الرئيس الروحي لدروز السويداء الشيخ حكمت الهجري، في بيانٍ صدر عنه صبيحة اليوم التالي لقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
واعتبر الهجري أن “أي انتصار للوطن إنما هو انتصار لحقوق كل السوريين”، وقال في بيانه “بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعشْ جميعا كشركاء تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها وتلاوينها”.
وبرأي عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، فإن قرار رفع العقوبات عن سوريا “سينقل البلاد من حالة الفشل والانهيار إلى مرحلة بناء الدولة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي”.
وقال للجزيرة نت، إن قرار رفع العقوبات يمثّل “فرصة حاسمة” ينبغي استثمارها من أجل إعادة مسارات العملية السياسية الجارية في سوريا إلى نصابها الصحيح، ومراجعة العديد من الأسس التي قامت عليها، مع التركيز بشكل خاص على قضية المشاركة الشعبية في المرحلة الانتقالية.
ويعتقد درويش أن معظم أهالي السويداء يؤيدون وحدة البلاد، وبناء المؤسسات وفق معيار الدولة الحديثة. وبالتالي، فإنهم ضد إسقاط المرحلة الانتقالية. لكنهم “يطالبون بفتح مسار وطني جامع، يهدف إلى تقويم الانزياح والانحراف السياسي والدستوري” على حد وصفه.
تراجع الخطاب الانفصالي
ولم يستطع الخطاب الانفصالي الذي جرى ترويجه خلال الأسابيع الماضية في السويداء من المضي كثيرا أو التوسّع داخل الفضاء السياسي للدروز، كما يرى المراقبون. وأخفق دعاة هذا المشروع السياسي في تنظيم وقفات احتجاجية داخل ساحة الكرامة وسط المدينة، والتي شهدت فيما مضى انتفاضة شعبية واسعة بدأت في صيف العام 2023 واستمرت حتى سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
يقول المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، إن “المزاج العام في السويداء وطني الهوى ووجهته دمشق، وكنّا سمعنا وشاهدنا تصريحات موثّقة لمعظم القيادات الروحية والاجتماعية، ومعظم الفصائل المسلّحة في المحافظة، تؤكد على نبض أبناء السويداء الوطني بالرغم من بعض الاختلاف، وهو أمر طبيعي وصحيّ لا ينذر بأي سوء”.
وقال أبو طافش للجزيرة نت إن “المطالبة بالإدارة الذاتية أو الحماية الدولية ليست مطالب شعبية عامة، ولم تلقَ تأييدا لدى الجميع، وأبناء السويداء سيكونون سباقين إلى بناء الدولة السورية ومؤسساتها..”.
وباعتقاد المتحدث، فإن “مشكلة الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع ليست مع السويداء، فالسويداء وأبناؤها لن تكون حجر عثرة في طريق بناء الدولة الوطنية السورية القوية، الدولة الديمقراطية التشاركية التي تُعبّر عن أحلام السوريين”. وبرأيه فإن المشكلة تكمن مع بعض المجموعات غير المنضبطة، والتي ارتكبت الانتهاكات، وسببت توترا في حياة السوريين، على حد وصفه.
وأيده الأمين العام للتحالف الوطني السوري لدعم الثورة خالد جمول، الذي قال إن أغلبية المكونات في السويداء هي مع الحكومة السورية، ومع بناء دولة القانون. وأضاف للجزيرة نت أن “طلب الحماية الدولية الصادر عن بعض الشخصيات في السويداء لا يمثّل إلا مجموعة أو فئة معينة ضيّقة، وأغلبية أبناء السويداء ترفض أي تقسيم، وتميل إلى اللامركزية الإدارية غير الموسّعة”.
وشدد على أن السويداء تؤكد استمرار ارتباطها بالدولة السورية، ولا تفكر بالانفصال عنها، كما ويسود لدى دروز السويداء ارتياح بشأن المستقبل القريب، وما قد يحمله من انفراجات ملموسة على الصعيدين المعيشي والاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد شرعت بخطوات تهدف لاعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحديث الجهاز الشرطيّ والأمنيّ، مع الحفاظ على مركزيّة القرار فيه، بحيث سيتم تقسيم البلاد إلى 5 قطاعات جغرافيّة يشرف على كل منها معاون خاص لوزير الداخلية.
المصدر : الجزيرة
——————————-
عقيدة المحيط.. هل تسعى إسرائيل لحرق العرب بنار “الأقليات”؟/ شادي إبراهيم
19/5/2025
في كتابه “مهمة الموساد في جنوب السودان: 1969-1971″، يكشف ضابط الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد بن عوزيل تفاصيل العمليات السرية التي نفذتها إسرائيل، لدعم متمردي حركة أنيانيا الجنوبية في السودان، إبان التمرد الذي شنه الجنوبيون في ستينيات القرن الماضي ضمن وقائع ما عُرفت لاحقا بـ”الحرب الأهلية السودانية الأولى”.
ويوضح بن عوزيل، المعروف حركيا باسم “طرزان” في جهاز الاستخبارات، أن هذا الدعم شمل نقل أسلحة ومعدات اتصال متطورة إلى المتمردين، إضافة إلى تدريب مقاتلي الحركة على يد فريق من الضباط الإسرائيليين، كما امتد إلى التخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية شملت تفجير الجسور وإغراق قوارب التموين، إلى جانب نصب كمائن استهدفت وحدات الجيش السوداني.
يقدم الكتاب وقائع انفصال الجنوب السوداني في عام 2011 باعتباره نجاحا خاصة للموساد، وإنجازا لعملية إسرائيلية استمرت لعقود طويلة عمدت خلالها إسرائيل إلى دعم التمرد في جنوب السودان وبناء القوة العسكرية وحتى الاقتصادية للانفصاليين الجنوبيين.
أكثر من ذلك، في مقابلة لاحقة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أشار بن عوزيل إلى أن الغرض الأساسي من التحالف مع “أنيانيا” كان “استنزاف قدرات الخرطوم، ودفعها إلى تركيز قواتها جنوبًا، بعيدًا عن ساحات المواجهة العربية مع إسرائيل”، مما يعني أن ذلك الدعم كان في جوهره توظيفًا لأقلية عرقية واستخدامها أداةً ضغط على دولة عربية في المنطقة، وهو ما يعدّ تطبيقا مبكرًا لـ”عقيدة المحيط”، التي صاغها ديفيد بن غوريون ومستشاره إلياهو ساسون، في مطلع خمسينيات القرن الماضي.
أحزمة الفتنة
تقوم “عقيدة المحيط” على إستراتيجية مزدوجة تعتمد على تطويق المنطقة بحزامين من التوترات، يستهدف الأول تأزيم العلاقات بين الدول العربية وجيرانها الإقليميين (خاصة من الدول الإسلامية غير العربية)، مما يشغل هذه الدول بصراعات بعيدة عن إسرائيل ويستنزف مواردها في نزاعات جانبية.
أما الحزام الثاني، فيرتكز على توظيف أقليات الشرق الأوسط، خاصة في النطاق المحيط بفلسطين، عبر فصلهم عن مجتمعاتهم وربطهم بمعادلة الأمن الإسرائيلي، مما يدفعهم للتحالف مع تل أبيب، تحت ضغط المخاوف التي غذتها إسرائيل بنفسها منذ البداية.
هذا النهج لم يكن مجرد نظرية، بل خطة عملية تجسدت في بناء إسرائيل شبكة من التحالفات مع دول غير عربية، مثل تركيا وإثيوبيا وإيران خلال عهد الشاه في محاولة لعزل هذه الدول عن جيران إسرائيل العرب، فضلا عن دعم جماعات محلية مثل الأكراد في العراق، والدروز في سوريا، والموارنة في لبنان، وحركات التمرد في جنوب السودان ودارفور.
ولم يكن الهدف الفعلي هو دعم هذه الأقليات أو “تحريرها”، بل تحويلها إلى أدوات تخدم المصالح الإسرائيلية عبر شعارات وعناوين برّاقة.
كان السودان هو المثال الأوضح لتطبيق هذه السياسة، ودفع ثمنها على المدى الطويل، حيث دعمت إسرائيل متمردي أنيانيا بالأسلحة والتدريب، بغية استنزاف السودان وتشتيت موارده في نزاع ممتد.
وحينما حصل جنوب السودان على استقلاله عام 2011، لم يجلب هذا الاستقلال استقرارًا، إذ سرعان ما انزلقت البلاد في حرب أهلية جديدة عام 2013، وهي نتيجة طبيعية لإرث الصراع والتسلح الذي تمت تغذيته لعقود طويلة.
فوفقًا لدراسة صادرة عن مشروع “مسح الأسلحة الصغيرة” (Small Arms Survey)، وهو مؤسسة دولية معنية بدراسة انتشار الأسلحة الخفيفة وتأثيرها في مناطق النزاع، أدى تدفق الأسلحة الخارجية إلى أنيانيا خلال الحرب الأهلية الأولى إلى تراكم ترسانة عسكرية ضخمة، استمرت في تغذية دوامة العنف لفترة طويلة لاحقة.
يتقاطع ذلك مع رؤية المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، التي أشار إليها في موسوعته “اليهود واليهودية والصهيونية”، حيث لفت إلى أن “المشروع الصهيوني” يستند إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى “البلقنة”، أي تفكيك الدول العربية إلى كيانات صغيرة متصارعة، والثانية ربط المصالح الاقتصادية لهذه الدول، وخاصة المجاورة، بالاقتصاد الإسرائيلي، بما يضمن تبعيتها واستمرار نفوذ تل أبيب عليها.
بناءً على هذا، يرى المسيري أن العالم العربي تم تقسيمه من قبل إسرائيل إلى أربع دوائر جيوسياسية، مع تحديد آلية التعامل مع كل منها، بغرض ضمان هيمنة إسرائيل الإقليمية. ففي الدائرة الأولى منطقة الهلال الخصيب، حيث سوريا والعراق والأردن، تعمل إسرائيل على تقسيم سوريا إلى دويلات عرقية وطائفية: دولة علوية على الساحل، وأخرى سنية في حلب، وثالثة سنية معادية لها في دمشق، ورابعة درزية في حوران والجولان.
أما العراق، فيقُسّم في الرؤية الإسرائيلية إلى دولة شيعية في الجنوب حول البصرة، وسنية حول بغداد، وكردية في الشمال حول الموصل، مع الحرص على ألا تتحول الثروة النفطية إلى تهديد لأمن إسرائيل. لبنان بدوره خُطّط أيضًا لتقسيمه إلى خمس مناطق طائفية: درزية في الشوف، ومارونية في كسروان، وشيعية في الجنوب والبقاع، وسنيّتين في طرابلس وبيروت.
الدائرة الثانية تضم مصر والسودان، حيث تسعى إسرائيل إلى زعزعة مكانة مصر في قيادة العالم العربي، عبر إذكاء التوترات الطائفية، وتقويض الدولة المركزية، ودفع البلاد نحو التفكك إلى كيانات هشة بلا سلطة موحدة.
كما أن فصل جنوب السودان عن شماله حوّله إلى نقطة ضعف إستراتيجية على خاصرة مصر، بحسب رؤية المسيري. بعد ذلك تأتي الدائرة الثالثة التي تضم دول الخليج العربية والدائرة الرابعة وتحوي دول المغرب العربي وكلاهما ترغب إسرائيل في تحييدها بشكل دائم عن دائرة الصراع.
من جوبا إلى السويداء
وبعد أكثر من نصف قرن من تسليح أقليات جنوب السودان، تعود “عقيدة المحيط” إلى الواجهة، مع دخول دروز الجنوب السوري إلى دائرة الأضواء الإسرائيلية حيث تستخدمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي أداةً للضغط على النظام الجديد في سوريا وذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية في البلاد بدعوى “حماية الدروز”.
وعلى عكس الصورة النمطية؛ لا يعدّ الدروز جماعة موحدة أو كتلة متجانسة، فهم مجموعات متعددة تختلف في رؤاها السياسية وتوجهاتها، فبعضهم يدعم التحالف مع إسرائيل، بحثًا عن حماية أو مصالح خاصة، بينما يرفض آخرون هذا النهج ويفضلون الاندماج في إطار الدولة التي يعيشون فيها.
هذا التباين في المواقف لم يغب عن حسابات إسرائيل التي سعت إلى استغلاله منذ وقت مبكر، ففي عام 1948، أنشأ جيش الاحتلال “كتيبة السيف”، وهي وحدة مشاة خفيفة ضمت جنودًا من الأقليات، كان معظمهم من الدروز، إلى جانب مجندين من القبائل البدوية والشركس والمسيحيين. عُرفت هذه الوحدة لاحقًا باسم “وحدة الأقليات” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت منفصلة عن الهيكل العسكري الأساسي. وكان للدروز وضع فريد من نوعه، فقد خضعوا لتجنيد إجباري، بشكل مشابه لتجنيد اليهود، بينما سُمح للأقليات الأخرى بالانضمام طواعية.
ومع مرور الوقت، انتقلت إسرائيل من سياسة الفصل إلى الدمج التدريجي، خاصةً مع الدروز الذين أصبحوا جزءا من الجيش الإسرائيلي، بعد إغلاق وحدة الأقليات عام 2015، خلال فترة رئيس الأركان غادي آيزنكوت.
لكن تلك السياسة أثبتت نجاحها مع الدروز أكثر من غيرهم، حيث ظلت الأقليات الأخرى تواجه فحوصات أمنية مشددة وعراقيل مؤسسية، تحدّ من ترقية أفرادها في المؤسسات العسكرية والأمنية، بسبب أزمة ثقة مستمرة تتعلق بولائهم.
ورغم هذا “الاندماج العسكري”، ظلت النظرة الإسرائيلية إلى الدروز قائمة باعتبارهم أداة قابلة للتوظيف ضمن إطار “عقيدة المحيط”.
يتضح ذلك في تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي دعا خلالها إلى “بناء تحالفات مع الأقليات الأخرى” في المنطقة، باعتبار أن إسرائيل ستبقى دائمًا أقلية في محيطها، وخص ساعر بالذكر الدروز والأكراد في سوريا، واعتبرهم حصنا منيعًا في مواجهة الأغلبية العربية السنية التي هللت، بحسب وصفه، عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية الحدود الإسرائيلية مع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ينسجم هذا مع تحليل دان ديكر، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة، الذي طالب المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي ببناء شبكة تحالفات إقليمية تمتد من شمال غرب إفريقيا إلى إيران، قائمة على التعاون مع الأقليات مثل الأذريين، والبربر، والشركس، والأكراد، والإزيديين.
ويرى ديكر أن هذه الأقليات، التي يزيد تعدادها عن 100 مليون نسمة، تشكل ركائز محتملة لنفوذ إسرائيلي واسع في منطقة تتسم بهشاشة الدول المركزية التي تحتضنها.
وفي وقت لاحق، تزامنا وسقوط نظام بشار الأسد، كشف ساعر عن اتصاله المباشر مع الأقليات في سوريا، مشددًا على أن إسرائيل، كأقلية إقليمية، تحتاج إلى بناء تحالفات مع الأقليات الأخرى في المنطقة لحماية مصالحها، وخصّ بالذكر الأكراد والدروز، مشيرًا إلى أن الأكراد يفتقرون إلى الاستقلال السياسي، رغم تمتعهم بحكم ذاتي جزئي في سوريا والعراق.
وفي مايو/أيار الجاري، صعّد ساعر خطابه؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى حماية الأقلية الدرزية في سوريا، محذرًا من “عصابات الإرهاب” التابعة للنظام السوري التي تستهدفهم، بما يعكس تزايد الاهتمام الإسرائيلي بتوظيف الأقليات كأوراق ضغط إقليمية، وهو توجه يعزز نفوذ تل أبيب في مناطق الهشاشة والفراغ السياسي.
تزامن ذلك وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات على البنية العسكرية السورية، تحت ذريعة حماية الأقلية الدرزية، وهي سردية استخدمتها إسرائيل طوال الأشهر التي تلت سقوط نظام الأسد، في تبرير تدخلها العسكري في سوريا ومحاولتها إجهاض قدرة النظام الجديد.
ورغم أن بعض الأصوات الدرزية في سوريا تميل إلى تأييد رواية إسرائيل بشأن حماية الدروز، فإن هذه الأصوات تبقى هامشية مقارنة بغالبية الدروز في سوريا ولبنان، الذين يرفضون هذا التدخل ويرون فيه مصدرًا لتوتر متصاعد بين الدروز وبقية السوريين، مما يهدد بإشعال صراع داخلي في الطائفة الدرزية نفسها، ويهدد النسيج الطوائفي السوري بشكل أوسع.
وصفة الفوضى تتكرر
هكذا ينتقل الدعم الإسرائيلي نفسه من أدغال جوبا إلى جبال السويداء، حاملًا معه الوصفة ذاتها: استنزاف الدول المركزية وتحويل الأقليات إلى بيادق في لعبة أكبر، حتى لو تغيّر اللاعبون وتبدلت خرائط الصراع.
بيد أن هذا أثار أسئلة عدة داخل المجموعات الدرزية في السويداء، أهمها يتعلق بمدى الثقة في التحالف مع إسرائيل، فإذا ما كانت الجغرافيا تفصل الدروز عن جوبا، فالتجربة اللبنانية تلوح أمامهم كتحذير واضح، فقد تحالفت المليشيات المسيحية مع تل أبيب لكنها انتهت إلى الانهيار أو النزوح، بمجرد أن غيَّرت إسرائيل أولوياتها.
كانت البداية في مايو/أيار 1976، عندما سلّحت إسرائيل مليشيات الجبهة اللبنانية وزوّدتها بالمستشارين العسكريين، بغرض تحويلها إلى خط دفاع أول في وجه الفصائل الفلسطينية. وسرعان ما برزت “القوات اللبنانية” بقيادة بشير الجميّل كنموذج لتحالف مصلحة بين تل أبيب والأقلية المارونية، مقابل تعهّد الأخيرة بحماية الحدود الشمالية لإسرائيل.
تلا ذلك تأسيس جيش لبنان الجنوبي عام 1978، وهو قوّة مسيحية مارونية خالصة تلقت تدريبًا وتسليحًا إسرائيليًّا كثيفًا وعملت ذراعًا ميدانية لتل أبيب في قتال منظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقًا في قتال حزب الله. لكن مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000، انهار الجيش الجنوبي وفرّ كثير من أعضائه إلى إسرائيل.
تفتح هذه الوقائع نقاشًا داخليًّا بين الدروز، فالتحالف مع قوى خارجية قد يوفّر سلاحًا وحماية لحظية، لكنه يترك الأقليات مكشوفةً أمام تقلبات المزاج السياسي في تل أبيب ومن خلفها واشنطن. ويزيد هذا القلق مع توجه الإدارة الأميركية إلى خفض وجودها العسكري في سوريا.
فإذا تركت الولايات المتحدة المنطقة بعد استقطاب الدروز من قبل إسرائيل وفصلهم عن نسيجهم السوري، فسوف يجد هؤلاء أنفسهم أمام خياريْن كلاهما مُرّ، إما البقاء “كتيبة” تحت إمرة الجيش الإسرائيلي وحمايته، أو ترك أوطانهم والنزوح إلى الجليل الأعلى داخل الحدود الإسرائيلية الحالية.
وبشكلٍ مماثل، تضيف التجربة الكردية عِبرةً أخرى، فقد دعمت إسرائيل البشمركة الكردية بالسلاح والتدريب بين عامي 1961 و1970، أثناء الحرب العراقية الكردية الأولى وما بعدها، لكن هذا التحالف انتهى فعليا عام 1975، عقب توقيع “اتفاقية الجزائر” بين العراق وإيران، وتعهد الأخيرة بوقف الإمدادات عن الأكراد.
واليوم يعاد رسم اللوحة، فقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تحالفت أمنيًّا مع واشنطن، سارعت إلى البحث عن غطاء إسرائيلي في مواجهة تقارب دمشق وأنقرة بعد سقوط نظام الأسد، في حين تلمّح سفيرة الإدارة الذاتية الكردية إلهام أحمد إلى أن “أمن سوريا يحتاج مشاركة إسرائيل”.
غير أن الاتفاق الذي أُبرم في مارس/آذار الماضي بين الحكومة السورية وبين قوات سوريا الديمقراطية ربما يقطع الطريق -ولو مؤقتا- أمام لعب إسرائيل بالورقة الكردية في سوريا، خاصة مع اتجاه إدارة ترامب للرهان على الحكومة السورية الجديدة ورفع العقوبات عنها، وهو ما يعني التخلي عن تحالفها المستقل مع الأكراد.
لكن ذلك لا يعني أن “عقيدة المحيط” الإسرائيلية سوف تخفت في وقت قريب. فلا تزال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتقاطر حول ضرورة “حماية الدروز والمسيحيين” في ضواحي دمشق، بالتوازي مع غارات جوية متكررة على البنية العسكرية السورية بذريعة توفير هذه الحماية.
لكن التاريخ يُظهر أن مثل هذه التدخلات كثيرًا ما أدت إلى تحوّل الصراع المحلي إلى حرب إقليمية تدفع ثمنها أولا الأقلية التي يتم توظيفها.
هكذا تُعاد الحلقة: وعدٌ بالحماية، يليه تصعيدٌ طائفي وتدفّق سلاح، ثم خذلان عند أوّل منعطف جيوسياسي. في غضون ذلك، لا تستنكف إسرائيل على ما يبدو أن تستنسخ سياساتها القديمة ذاتها مع أقلية جديدة في ساحة حرب جديدة، تاركةً السؤال ذاته مفتوحًا: كم مرة من التكرار يحتاج التاريخ، كي يقنع الضحايا بأن بندقية الحليف الإسرائيلي مؤقتة وأنها لا تخدم إلا مصالحه؟
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية
——————————————-
==========================
العدالة الانتقالية تحديث 19 أيار 2025
—————————————-
مقالان في “العدالة الإنتقالية/ فضل عبدالغني
المقال الأول
هكذا سيُحاسب المجرمون السابقون في سوريا/ فضل عبد الغني
11/5/2025
شهد يوم الأحد، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منعطفًا تاريخيًا في المشهد السوري مع إعلان سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية، متبوعًا بتعيين حكومة تسيير أعمال مؤقتة.
يأتي هذا التحول بعد أربعة عشر عامًا من النزاع المسلح الدموي الذي بدأ مع انطلاق الحراك الشعبي السلمي في مارس/ آذار 2011، عندما خرج السوريون مطالبين بالحرية والكرامة وبناء دولة ديمقراطية تقوم على انتخابات حرة ونزيهة.
مع نهاية حقبة حكم آل الأسد التي امتدت لأكثر من نصف قرن، تواجه سوريا تحديات هائلة تتطلب إرساء أسس جديدة للعدالة والسلم الأهلي. وفي هذا السياق، تبرز العدالة الانتقالية كنهج أساسي للانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة.
لعبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في توثيق الانتهاكات بشكل يومي منذ عام 2011. فقد عملت على بناء قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان، تضمنت تقارير يومية وشهرية تغطي سنوات النزاع. وقد شكلت هذه التوثيقات أساسًا متينًا يمكن الاستناد إليه في أي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا.
وفقًا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النزاع السوري خلّف حصيلة مروعة من الانتهاكات، تشمل:
مقتل ما لا يقل عن 234 ألف مدني، بينهم 202 ألف قتلوا على يد قوات نظام الأسد.
توثيق 181 ألف حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بينهم 160 ألف مختفٍ قسريًا على يد النظام، بينهم 3.736 طفلًا و8.014 سيدة.
وفاة ما لا يقل عن 45.336 شخصًا تحت التعذيب، بينهم 45.031 شخصًا على يد قوات النظام.
استخدام أسلحة مدمرة على نطاق واسع، بما في ذلك إلقاء 81.916 برميلًا متفجرًا، وتنفيذ 217 هجومًا بأسلحة كيميائية، و252 هجومًا بذخائر عنقودية، و51 هجومًا بأسلحة حارقة.
نزوح وتشريد نحو 13.8 مليون سوري، بينهم 6.8 ملايين نازح داخليًا وقرابة 7 ملايين لاجئ خارج البلاد.
هذه الإحصاءات المروعة تعكس حجم المأساة السورية وتبرز الحاجة الملحة لتبنّي مسار شامل للعدالة الانتقالية يعالج هذا الإرث الثقيل من الانتهاكات، ويضمن عدم تكرارها، ويمهد الطريق نحو بناء سوريا جديدة قائمة على أسس العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وهذا ما تحاول رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان للعدالة الانتقالية في سوريا تقديمه. تتميز هذه الرؤية التي صدرت قبل أيام، بكونها نهجًا شاملًا يسعى لمعالجة جذور المشكلات التي عانت منها سوريا عبر عقود، وتحقيق تحوّل نوعي في بنية الدولة السورية ومؤسساتها.
تقترح الشبكة في رؤيتها إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تشكل المحور الرئيسي لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية، وتتسم بالاستقلالية والشمولية والشفافية.
كما تؤكد الرؤية على ضرورة تطبيق الأركان الأربعة للعدالة الانتقالية بشكل متزامن ومتكامل، بحيث تتضافر جهود المحاسبة الجنائية مع مساعي كشف الحقيقة وبرامج جبر الضرر وإصلاح المؤسسات.
وتولي الرؤية اهتمامًا خاصًا بالمشاركة المجتمعية الواسعة في مسار العدالة الانتقالية، مع التركيز على دور الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وأهمية التعاون الدولي كداعم أساسي للعملية، مع الحفاظ على الملكية الوطنية للمسار بأكمله.
ونحاول في هذا المقال رصد عدد من هذه الجوانب التي غطتها الرؤية، على أن نكملها في مقال لاحق.
1- الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية
العدالة الانتقالية في الحالة السورية هي مجموعة من الآليات القانونية وغير القانونية التي تهدف إلى معالجة الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاع، وخاصة تلك التي ارتكبها نظام الأسد، من أجل تحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة المسؤولين، وتعزيز المسار نحو سلام دائم يستند إلى القانون وحقوق الإنسان.
ترتكز العدالة الانتقالية في سوريا على أربعة أركان أساسية متكاملة: أولها؛ المحاسبة الجنائية، التي تشكل حجر الزاوية لتكريس سيادة القانون وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، مع التركيز على محاسبة القيادات العليا المتورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ثانيها؛ الحقيقة والمصالحة، التي تهدف إلى توثيق الانتهاكات، وتحديد مصير المفقودين والمختفين قسريًا (الذين يتجاوز عددهم 160 ألف شخص)، وتعزيز المصالحة المجتمعية.
ثالثها؛ جبر الضرر والتعويض، الذي يشمل التعويض المادي للضحايا وذويهم، وبرامج جبر الضرر المعنوي وتخليد الذكرى.
رابعها؛ إصلاح المؤسسات، خاصة القضائية والأمنية والعسكرية، لضمان عدم تكرار الانتهاكات واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
تُعد العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لنجاح الانتقال السياسي في سوريا، إذ لا يمكن تحقيق استقرار مستدام دون التصدي للانتهاكات السابقة وضمان عدم تكرارها. فهي تهيئ الأرضية لنظام سياسي قائم على سيادة القانون والمساءلة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ويفتح المجال لمرحلة جديدة قائمة على التعددية والديمقراطية.
كما أنها تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتفكيك منظومات القمع والاستبداد التي سادت لعقود، مما يمنع انزلاق البلاد نحو دورات جديدة من العنف.
2- إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية
يقوم الإطار الدستوري والقانوني لهذه الهيئة على ركائز محددة، حيث يتولى المجلس التشريعي المُشكل بعد صدور الإعلان الدستوري مسؤولية وضع قانون تأسيسي ينظم مسار العدالة الانتقالية.
يستند هذا القانون إلى القوانين الوطنية والدولية، ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتضمن فصولًا رئيسة تشمل التعريفات والمبادئ العامة، وهيكلية الهيئة، وآليات العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات.
تتألف هيكلية الهيئة من مجلس إدارة يضم خبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني والضحايا، وأمانة عامة تعمل كجهاز تنفيذي، تشمل فرقًا إدارية وقانونية، ومالية، وإعلامية، وتقنية.
كما تضم الهيئة مكاتب محلية في كافة المحافظات السورية، وقسمًا للعلاقات الدولية يتولى التنسيق مع الجهات الدولية، وقسمًا للمراقبة والتقييم.
وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة تشمل استدعاء الشهود، وجمع الأدلة، والاطّلاع على الوثائق الرسمية والخاصة، والتحقيق في الانتهاكات، والطلب من القضاء إصدار أوامر توقيف، مع إلزام جميع الكيانات الحكومية بالتعاون معها.
لضمان استقلالية الهيئة، ينصّ القانون التأسيسي بوضوح على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، حمايةً لها من التدخل السياسي. كما تُخصص للهيئة ميزانية مستقلة تُقرّ من قبل السلطة التشريعية، بما يضمن عدم تبعيتها ماليًا للسلطة التنفيذية.
وعلى الرغم من استقلالها عن وزارة العدل، تعمل الهيئة في ظل النظام القضائي السوري، متولية مهام الكشف عن الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وتعويض الضحايا، والمساهمة مع السلطة القضائية في تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
فيما يتعلق بمعايير اختيار أعضاء الهيئة، تُعتمد الكفاءة والنزاهة أساسًا، حيث يجب أن يمتلك الأعضاء خبرة واسعة في مجالات حقوق الإنسان أو القانون، مع سجل نظيف من أي تورط في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يراعى التنوع والتمثيل، بحيث تعكس الهيئة تنوّع المجتمع السوري من حيث الجنس والعرق والدين والخلفية الجغرافية، مع ضرورة استقلال الأعضاء عن الأحزاب السياسية والفصائل المختلفة.
أما آلية التعيين، فتبدأ بتشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا، لترشيح الأسماء المقترحة، ثم انتخاب عشرة منهم لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، الذي يتولى بدوره تعيين واختيار فريق العمل وفق معايير الكفاءة والخبرة، مع مراعاة تمثيل الجهات المعنية بالعدالة الانتقالية وعلى رأسها الضحايا.
3- المحاسبة الجنائية
تشكل المحاسبة الجنائية حجر الزاوية في عملية العدالة الانتقالية، إذ تلعب دورًا محوريًا في تكريس سيادة القانون، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب التي سادت خلال حكم الأسد.
وقد حدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نهجًا واضحًا لتحديد الأولويات في المحاسبة، يركّز على القيادات العليا من الصفَّين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، باعتبارهم المسؤولين الرئيسين عن وضع خطط الانتهاكات والإشراف على تنفيذها.
ويمثل هذا النهج إستراتيجية واقعية للتعامل مع التحديات اللوجيستية والمالية التي تواجه عملية المحاسبة الشاملة، مع ضمان فتح المجال أمام الضحايا لرفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين المباشرين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم.
يتطلب تحقيق المحاسبة الجنائية إطارًا قانونيًا خاصًا، نظرًا لعدم توافق القوانين المحلية السابقة مع المعايير الدولية، وافتقارها إلى أحكام واضحة لمعالجة الجرائم الكبرى.
لذا، تقترح الرؤية إنشاء لجان قانونية مختصة مؤلفة من خبراء محليين ودوليين لصياغة قوانين جنائية جديدة، تشمل تعديلات جوهرية مثل: إدراج تعريفات واضحة للجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلغاء القوانين التي توفر الحصانة للمسؤولين، تطوير تشريعات تتيح محاكمة الجرائم بأثر رجعي، وضع قوانين تحدد صلاحيات المحاكم المكلفة بالنظر في الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحماية القانونية للضحايا والشهود.
كما تدعو الرؤية إلى التصديق على نظام روما الأساسي أو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12(3)، بما يسمح للمحكمة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ مارس/ آذار 2011.
تلعب لجان تقصي الحقائق دورًا محوريًا في جمع الأدلة الجنائية اللازمة للمحاسبة، من خلال الوصول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية لجمع الملفات والوثائق التي تكشف عن هويات المعتقلين والمختفين قسريًا وضحايا التعذيب.
تشمل هذه المؤسسات الأفرع الأمنية والسجون، دوائر السجل المدني، المشافي العسكرية والمدنية، المحاكم والدوائر القضائية، ومراكز رعاية الأيتام.
كما تقوم اللجان بتحليل البيانات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وإعداد تقارير مفصلة تتضمن نتائج التحقيقات وتحديد المسؤولين المحتملين عن الانتهاكات، مع تقديم توصيات للإصلاح والمساءلة.
وتعتمد هذه اللجان على مبادئ الاستقلال والنزاهة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشفافية والمشاركة العامة، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي وثّقت الانتهاكات.
نظرًا لفقدان القضاء السوري استقلاليته ومحدودية موارده، تقترح الرؤية تشكيل محاكم خاصة مختلطة متخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تتميز هذه المحاكم بكونها هيئات قضائية مؤقتة، تجمع بين العناصر الوطنية والدولية، مما يوازن بين الملكية المحلية والمعايير الدولية. يتم إنشاؤها على الأراضي السورية بواسطة النظام القضائي المحلي بالتعاون مع خبراء دوليين، وتتكون من قضاة ومحامين سوريين موثوقين وخبراء دوليين.
تعمل هذه المحاكم بشكل مستقل تمامًا عن السلطة التنفيذية، وتخضع للرقابة المدنية من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع العمل ضمن إطار قانوني محلي يحترم المعايير الدولية.
لملاحقة المسؤولين الفارين خارج البلاد، تقدم الرؤية مجموعة من الآليات الدولية، منها: طلب التعاون الدولي استنادًا إلى معاهدات دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اتفاقيات تسليم المجرمين، الاستفادة من مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تعتمده بعض الدول ويسمح لها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية حتى إذا ارتُكبت خارج أراضيها، واستخدام الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتسليم المطلوبين.
تواجه هذه الآليات تحديات متعددة، أبرزها احتمالية فرار المتهمين إلى دول ترفض تسليمهم، وغياب الالتزام القانوني للدول بالتسليم في حال عدم وجود اتفاقيات، وبطء الإجراءات الدولية.
لمواجهة هذه التحديات، توصي الرؤية بتعزيز الضغوط الدولية، التفاوض على اتفاقيات ثنائية جديدة للتسليم، ممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على الدول المؤوية للمتهمين، وتقديم أدلة قوية تدينهم أمام المحاكم الدولية.
4- الحقيقة والمصالحة
يمثل كشف الحقيقة ركنًا أساسيًا في مسار العدالة الانتقالية، كونه يساهم في معالجة إرث الانتهاكات وبناء الثقة المجتمعية، مما يمهّد الطريق نحو المصالحة الوطنية.
توثيق الانتهاكات وتحديد مرتكبيها يكتسب أهمية بارزة في السياق السوري لعدة أسباب، أبرزها: الكشف عن حقيقة الانتهاكات وآثارها المجتمعية، تحديد المسؤولين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، رأب الصدوع المجتمعية، وبناء ذاكرة وطنية جامعة.
تتطلب هذه العملية جمع شهادات من جميع الأطراف، بمن في ذلك المتورطون في الانتهاكات، مما يساعد في فهم البنية التنظيمية للانتهاكات وبناء السرد التاريخي وتخفيف الضغط عن النظام القضائي، إضافة إلى دعم المصالحة والشفاء المجتمعي.
ولمواجهة التحديات في هذا المسار، تقترح الرؤية تطبيق نظام العفو المشروط للأفراد الذين يعترفون بمسؤوليتهم ويقدمون معلومات قيمة، وإتاحة خيارات السرية للشهادات، وتنظيم جلسات استماع عامة خاضعة لضوابط، واعتماد نهج يركز على الضحايا.
بعد سقوط النظام السابق وفتح مراكز الاحتجاز، تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 160.123 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد النظام السابق، إضافة إلى ما لا يقل عن 16.898 مختفيًا قسريًا على يد بقية أطراف النزاع.
يشكل الكشف عن مصير هؤلاء المفقودين ركيزة أساسية في مسار الحقيقة، ويستلزم تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء في التحقيقات الجنائية، الطب الشرعي، علماء الجينات والأنثروبولوجيا، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المختصة مثل المؤسسة المستقلة للمفقودين (IIMP) واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
تعمل هذه اللجان بالتعاون مع السلطات الوطنية، المنظمات الحقوقية، الهيئات القضائية، وروابط الضحايا وذوي المختفين قسريًا، مما يضمن شمولية العملية وفاعليتها.
تشكل المقابر الجماعية نقطة انطلاق رئيسة لعمل لجان البحث عن المفقودين، إذ تم الكشف بعد سقوط النظام عن عشرات المواقع التي تحوي رفات المختفين قسريًا الذين قتلوا تحت التعذيب.
تتضمن خطوات التعامل مع هذه المواقع: حمايتها فورًا باعتبارها مسارح جريمة، إجراء البحث الميداني المنهجي وفق بروتوكولات دولية معتمدة، جمع الأدلة الجنائية لدعم التحقيقات، توثيق البيانات بدقة، إجراء تحقيقات شاملة تستند إلى المعايير الدولية، تحديد هويات الضحايا باستخدام تقنيات متطورة كتحليل الحمض النووي، والتواصل المستمر مع ذوي الضحايا ثم تسليمهم الرفات لدفنه بطريقة لائقة.
تلعب لجان الحقيقة دورًا محوريًا في تعزيز المصالحة المجتمعية، إذ تتجاوز المحاسبة الجنائية لتشمل آليات محلية تعالج المظالم وتبني الثقة. تشرف هذه اللجان على تشكيل مجالس عرفية ولجان مصالحة في المحافظات السورية، تضم وجهاء المجتمع وشخصيات قيادية ورجال دين، وتعمل على تسوية النزاعات المحلية، إعادة الحقوق إلى أصحابها، تعزيز المصالحة المجتمعية، ضمان الاعتذار والاعتراف بالمسؤولية، نشر ثقافة السلم الأهلي، وإعادة دمج المتضررين في المجتمع.
ويمكن الاستفادة من تجارب المجتمعات العشائرية في سوريا التي طورت آليات للصلح تشمل المسامحة ودفع الدية وتقديم الاعترافات العلنية.
تشكل هذه المحاسبة المحلية نهجًا رديفًا للمحاسبة الجنائية، يشجع الجناة الأقل تورطًا على الاعتراف والمشاركة في إصلاح الأضرار، مما يعزز العدالة التصالحية ويساهم في بناء آليات مستدامة لحل النزاعات ومنع دورات جديدة من العنف الانتقامي.
برامج جبر الضرر والتعويض
تُشكل برامج جبر الضرر والتعويض عنصرًا حيويًا في مسار العدالة الانتقالية السورية، وذلك لمعالجة الأضرار الهائلة التي خلفها النزاع والتي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بما فيها مقتل أكثر من 234 ألف مدني، واختفاء نحو 177 ألف شخص قسريًا، ووفاة أكثر من 45 ألف شخص تحت التعذيب، وتشريد نحو 13.8 مليون سوري.
تتنوع آليات التعويض المادي للضحايا وذويهم لتشمل: منح مادية مباشرة تُصرف دفعة واحدة أو على شكل رواتب طويلة الأجل للأرامل والأيتام، خدمات تفضيلية كالرعاية الصحية والتعليم المجاني، إعادة حقوق الملكية من خلال لجان محلية متخصصة لحل النزاعات على الممتلكات، تمويل مشاريع الإسكان عبر منح أو قروض بدون فوائد، دعم إعادة التأهيل الاقتصادي للأفراد، برامج تعويضات جماعية للمجتمعات المتضررة، تعويضات لخسائر الدخل، وتأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.
إلى جانب التعويضات المادية، تُولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا لبرامج جبر الضرر المعنوي وتخليد الذكرى، التي تساهم في تضميد جراح الضحايا والاعتراف بمعاناتهم واستعادة كرامتهم.
تشمل هذه البرامج: إعادة تأهيل الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، تقديم الدعم القانوني لمساعدتهم في المطالبة بحقوقهم، إنشاء نصب تذكارية كبرى في المناطق الأكثر تضررًا ونصب محلية مصغرة، تخصيص أيام تذكارية وطنية مصحوبة بفعاليات عامة ومعارض، إنشاء متاحف ومراكز توثيق تعرض شهادات الضحايا والصور، تطوير أرشيفات رقمية، إطلاق أسماء الضحايا على الأماكن العامة، تنظيم فعاليات ثقافية تخلد ذكراهم، تشجيع الاعتذارات العلنية والاعتراف بالتضحيات، إدماج إرث الثورة في المناهج التعليمية، وتنظيم عمليات شاملة لإحياء الذكرى بمشاركة أسر الضحايا والمجتمع المدني.
لتنفيذ هذه البرامج، تقترح الرؤية تشكيل لجان متخصصة للتعويض وجبر الضرر، تضم ممثلين حكوميين وقضاة وحقوقيين، ممثلين عن المجتمع المدني، ممثلين عن الضحايا وذويهم، ومستشارين دوليين؛ لضمان تنفيذ العملية وفق المعايير الدولية.
تتولى هذه اللجان تحديد الفئات المستهدفة بالتعويضات، أنواع الأضرار القابلة للتعويض، وضع آليات لتقدير حجم الضرر والتعويض المناسب، تصميم هيكلية للتعويضات تشمل التعويضات الفردية والجماعية والخدماتية، وتحديد كيفية توزيع التعويضات ضمن إطار زمني محدد.
ولتحديد قيمة التعويضات بشكل عادل، يجب التعاون مع المحكمة الجنائية الخاصة والاستفادة من توصيات لجان الحقيقة، مع أهمية التشاور مع المجتمعات المتضررة، وضمان احترام كرامة الناجين، وفرض آليات رقابة صارمة تضمن نزاهة وشفافية العملية.
تواجه برامج التعويض تحديات كبرى، أبرزها نقص الموارد المالية في ظل الدمار الاقتصادي الشامل الذي خلفه النظام السابق. لمواجهة هذا التحدي، تقترح الرؤية عدة إستراتيجيات: إقامة شراكات دولية مع مؤسسات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، اعتماد آليات تمويل مبتكرة كإنشاء صندوق ائتمان خاص، الاستفادة من الأصول والأموال المصادرة من مرتكبي الانتهاكات، الحجز على أموال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، الربط بين التعويض ومشاريع إعادة الإعمار، وتشجيع المساهمات المحلية والدولية.
كما تواجه البرامج تحديات أخرى كالتفاوت في توزيع التعويضات، والتعقيدات القانونية، والخلافات المجتمعية. لمواجهة هذه التحديات، توصي الرؤية بوضع معايير واضحة وعادلة للتعويضات، إجراء مسح شامل للأضرار، تعزيز الشفافية وإشراك الضحايا، تنويع خيارات التعويض، تطبيق نهج تدريجي ومرن، إنشاء هيئات قانونية متخصصة، وتنفيذ برامج حوار مجتمعي لتعزيز قبول عملية التعويض.
———————————–
المقال الثاني
3 تغييرات فورية يجب أن تقوم بها الإدارة السورية
بعد أن استعرضنا في الجزء الأول من هذا المقال الأُطر العامة لرؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشأن العدالة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك الخلفية التاريخية والسياسية، وركائز العدالة الانتقالية الأربعة، وهي: المحاسبة، الحقيقة والمصالحة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، نتناول في هذا الجزء الثاني بتفصيل أوسع ما تبقى من محاور هذه الرؤية.
نسلّط الضوء في هذا الجزء المتطلبات العملية لإصلاح مؤسسات الدولة، ونبحث في أهمية الدعم والتعاون الدولي، والتحديات المحتملة التي قد تواجه هذا المسار الحيوي نحو بناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.
سابعاً: إصلاح المؤسسات
يُشكل إصلاح المؤسسات الركن الرابع والأساسي للعدالة الانتقالية في سوريا، وهو ضمان أساسي لعدم تكرار الانتهاكات مستقبلًا. خلال عقود حكم نظام الأسد، تحولت مؤسسات الدولة الرئيسة، لا سيما القضائية والأمنية والعسكرية، من أدوات لخدمة المواطنين إلى وسائل للقمع وانتهاك الحقوق. لذا، فإن إعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة تُعد شرطًا لازمًا لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، وتحقيق الاستقرار المستدام.
يُعتبر إصلاح السلطة القضائيّة حجر الأساس في مسار العدالة الانتقالية، ويتطلب إعادة هيكلة شاملة تبدأ بتحرير مجلس القضاء الأعلى من هيمنة السلطة التنفيذية، عبر فصل رئاسة المجلس عن المنصب الرئاسي، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة في إدارة شؤون القضاء.
يتطلب ذلك إعادة صياغة قانون السلطة القضائية لحظر تدخل أي جهة تنفيذية في شؤون القضاء، وضمان الاستقلال المالي والإداري للجهاز القضائي، وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا. كما يجب إلغاء المحاكم الاستثنائية التي استُخدمت كأدوات للقمع، وإدماج اختصاصاتها في القضاء العادي، مع ضمان تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتطوير آليات الاستئناف والتمييز والرقابة القضائية على تنفيذ الأحكام.
ولضمان نزاهة القضاة وكفاءتهم، يجب وضع معايير موضوعية للتعيين والترقية تستند إلى الجدارة، وتحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي المحاكم، وتعزيز برامج التدريب المستمر ورقمنة العمل القضائي. وينبغي تفعيل دور نقابة المحامين وجمعيات القضاة المستقلة، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لتقديم تقارير دورية عن حالة القضاء وتدريب الكوادر ومراقبة المحاكمات.
تتطلب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تحولًا جذريًا في بنيتها وفلسفتها، إذ أوجد النظام السابق أجهزة أمنية متعددة ومتداخلة الصلاحيات خضعت مباشرة لرئيس الجمهورية وتورطت في انتهاكات جسيمة. يجب أولًا تقليص عدد الأجهزة الأمنية الموازية ودمج الأجهزة ذات المهام المتشابهة، وحل التشكيلات غير الرسمية، ووضع قوانين واضحة تحدد صلاحيات كل جهاز وتضمن خضوعه للمساءلة.
من الضروري إلغاء الصلاحيات القضائية للأجهزة الأمنية، وتفكيك شبكات المخبرين، وإنشاء هيئة رقابة مدنية مستقلة، وتعزيز دور البرلمان في الإشراف على أدائها. كما يجب تغيير العقيدة الأمنية بحيث تستند إلى حماية أمن الدولة والمواطنين لا النظام الحاكم، وإلغاء ثقافة العداء للمواطنين، وتطوير برامج تدريب مستمرة على حقوق الإنسان والمهارات التقنية.
وينبغي تجريم كافة أشكال التعذيب والانتهاكات، وإنشاء قنوات مستقلة للتحقيق في شكاوى المواطنين. وفيما يتعلق بالتوظيف، يجب اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الأمنية، بعيدًا عن الولاءات السياسية أو الطائفية، مع تحسين الرواتب والمزايا للحد من الفساد.
يشكل دمج الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني موحد تحديًا كبيرًا أمام الاستقرار وإعادة بناء الدولة. يجب وضع إطار سياسي وقانوني شامل يتضمن تشريعات واضحة لإعادة الهيكلة ودمج الفصائل وفق معايير مهنية، مع استبعاد المتورطين في جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة، وضمان شمولية العملية من خلال قبول الأفراد غير المتورطين من كافة الأطراف.
ويتطلب الأمر إنشاء لجنة تقييم مستقلة لتدقيق السجلات وقاعدة بيانات مركزية للفصائل المسلحة وأفرادها، مع برامج لتسوية أوضاع العناصر غير المتورطين بانتهاكات جسيمة. وينبغي تطوير برامج للتسريح وإعادة الإدماج المدني تشمل التدريب المهني، وفرص العمل، والدعم النفسي، والاجتماعي.
كما يجب إعادة توزيع القوى البشرية بشكل عادل على المناطق، وتحقيق الحياد في التشكيل العسكري، مع تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتحديث المناهج العسكرية وتوحيد معايير التدريب. ومن الضروري إعادة تنظيم القيادات العسكرية لتمثل جميع مكونات الشعب السوري، وإنشاء آليات شفافة للترقيات، وترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية، مع ضبط حيازة السلاح وتدمير الأسلحة المحظورة دوليًا. لضمان الرقابة والمساءلة، يجب إنشاء هيئة رقابة مستقلة ومحاكم عسكرية مختصة وتقييم دوري للإصلاحات، مع الاستفادة من المساعدة الفنية الدولية.
يتطلب نجاح إصلاح المؤسسات تعزيز الشفافية والمساءلة على كافّة المستويات، وذلك عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل؛ إنشاء هيئات رقابية مستقلة لكل مؤسسة، تفعيل دور البرلمان في الرقابة على أداء المؤسسات العامة، وضع مدونات سلوك ملزمة للعاملين في القطاعات الحساسة، تطوير قوانين تحمي المبلغين عن الفساد والانتهاكات، وإنشاء آليات فعالة للشكاوى مع ضمان سرعة معالجتها.
كما ينبغي إلزام المؤسسات الرسمية بنشر تقارير دورية عن أدائها ومصروفاتها، وإتاحة المعلومات للعموم وفق قانون حرية الوصول للمعلومات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، يجب تطوير نظم تقييم أداء موضوعية ودورية للمسؤولين والموظفين، وربط التعيينات والترقيات بالكفاءة والنزاهة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والحدّ من الفساد. وعلى المستوى الثقافي، ينبغي نشر ثقافة مجتمعية تؤمن بدور الرقابة المدنية وتشجع المواطنين على المساهمة في محاسبة المؤسسات، مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ثامناً: الدعم والتعاون الدولي
يلعب الدعم والتعاون الدولي دورًا محوريًا في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث يوفر المساعدات التقنية، والدعم المالي، والآليات القانونية التي تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. يساهم هذا التعاون في دعم الضحايا وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس عادلة، كما يمثل ضرورة ملحة نظرًا لتعقيد الحالة السورية وحجم الانتهاكات غير المسبوق وضعف الموارد المحلية. إضافة إلى ذلك، يضمن التنسيق الدولي تنفيذ آليات العدالة الانتقالية بفاعلية، ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويساعد في بناء قدرات المؤسسات الوطنية، مما يسهم في تحقيق مصالحة وطنية مستدامة تعيد الاستقرار إلى البلاد.
تشكل الآليات الدولية المتخصصة ركائز أساسية لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. تبرز من بينها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، والمكلفة بجمع الأدلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في سوريا وتحليلها وحفظها.
يمكن للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التعاون معها من خلال تبادل الوثائق والبيانات، والاستفادة من ملفات القضايا التي أعدتها لدعم عمل المحكمة الخاصة المقترحة. كما يوفر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) دعمًا فنيًا لبناء قدرات الفاعلين المحليين، مع إمكانية الاستفادة من خبراته في وضع أطر العدالة الانتقالية التي تركز على حقوق الضحايا.
أما اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا (COI)، التي أُنشئت في 2011، فتقدم توثيقًا وتحليلًا مستقلًا للانتهاكات، يمكن أن يدعم عمل لجان الحقيقة والمحكمة الخاصة. وتضطلع المؤسسة المستقلة للمفقودين (IIMP)، التي أُنشئت في 2023، بمعالجة قضية المفقودين في سوريا وتقديم الدعم لأسرهم، من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع اللجان المحلية.
تقدم المنظمات الحقوقية الدولية دعمًا قيمًا لجهود العدالة الانتقالية في سوريا. فقد وثقت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش (HRW) ومنظمة العفو الدولية، انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على مدار سنوات النزاع، مما يوفر أرشيفًا غنيًا يمكن استخدامه كأدلة لدعم عمل لجان الحقيقة والمحكمة الخاصة.
كما يمكن لهذه المنظمات مراقبة عمل هيئة العدالة الانتقالية، وتقديم النصح والتدريب لضمان التزامها بالمعايير الدولية. ومن جهتها، تتمتع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا المفقودين والمقابر الجماعية في سياقات معقدة، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرة في توسيع جهود جمع البيانات عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصيرهم باستخدام تقنيات متطورة كتحليل الحمض النووي، وتقديم الدعم النفسي لأسرهم.
يعتبر التعاون القضائي الدولي ضروريًا لتحقيق العدالة الشاملة، خاصة مع فرار العديد من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة خارج سوريا.
تشمل آليات هذا التعاون؛ تبادل المعلومات والأدلة مع المحاكم الدولية والأجنبية التي تنظر في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الاستفادة من الولاية القضائية العالمية التي تتيح للدول محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابها، التصديق على نظام روما الأساسي أو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12(3)، إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتسليم المطلوبين، وتدريب الكوادر القضائية المحلية على معايير المحاكمات الدولية.
لضمان فاعلية هذا التعاون، يجب إنشاء وحدة متخصصة ضمن هيئة العدالة الانتقالية للتنسيق مع الآليات الدولية، والعمل على بناء قاعدة بيانات مشتركة للانتهاكات والمتهمين، والمشاركة في شبكات التعاون الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.
تاسعاً: التحديات المحتملة وسبل مواجهتها
يواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا تحديات متعددة الأبعاد تتطلب إستراتيجيات شاملة لمواجهتها. على المستوى السياسي والأمني، تبرز صعوبة تحقيق توافق وطني حول آليات العدالة الانتقالية في ظل الاستقطاب السياسي الحاد. كما يشكل استمرار وجود جهات مسلحة متعددة الولاءات تحديًا كبيرًا للاستقرار وتنفيذ برامج العدالة، إذ قد تقاوم هذه الجهات جهود المحاسبة الجنائية خوفًا من المساءلة.
وتُعتبر مقاومة بقايا أجهزة النظام السابق وأنصاره عائقًا أمام الإصلاح المؤسسي، خاصة في القطاعات الأمنية والقضائية. إضافة إلى ذلك، تمثل التدخلات الإقليمية والدولية المتضاربة عقبة أمام إحراز تقدم في مسار العدالة، حيث تسعى قوى خارجية لتأمين مصالحها على حساب استقلالية القرار السوري.
لمواجهة هذه التحديات، يمكن اعتماد إستراتيجيات تشمل؛ تعزيز الحوار الوطني الشامل، بناء الإجماع حول أولويات العدالة الانتقالية، تطبيق خطة متكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بناء تحالفات دولية داعمة للعدالة الانتقالية، وتفعيل آليات الحماية للضحايا والشهود.
على الصعيد الاقتصادي والمالي، تعاني سوريا من انهيار اقتصادي شامل وبنية تحتية متهالكة، مما يحدّ من الموارد المتاحة لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية. تتطلب عمليات التوثيق، المحاكمات، برامج التعويض، وإعادة الإعمار موارد مالية ضخمة قد تفوق قدرة الدولة. وتواجه سوريا صعوبة في تحديد أولويات الإنفاق بين متطلبات العدالة الانتقالية والاحتياجات الأساسية العاجلة للسكان.
كما تشكل العقوبات الدولية والقيود المفروضة على التحويلات المالية عقبات أمام تمويل مشاريع العدالة الانتقالية. لمعالجة هذه التحديات، يقترح إنشاء صندوق دولي لدعم برامج العدالة الانتقالية، إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المزدوج في التعافي الاقتصادي وتحقيق العدالة، البحث عن مصادر تمويل بديلة كاسترداد الأصول المنهوبة ومصادرة أموال المتورطين في انتهاكات، وتطوير شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم برامج إعادة التأهيل وإعادة الدمج.
يشكل انعدام الثقة والانقسامات المجتمعية تحديًا جوهريًا أمام العدالة الانتقالية، حيث أدت سنوات النزاع إلى تعميق الانقسامات الطائفية والإثنية والسياسية، مما يعقد عملية المصالحة. وقد أدى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، خاصة الأمنية والقضائية، إلى صعوبة تقبل المواطنين أي إصلاحات تقودها هذه المؤسسات.
كما قد تسبب التباينات في فهم مفهوم العدالة بين المكونات المختلفة للمجتمع السوري صراعات حول أولويات ومسارات العدالة الانتقالية. ويساهم انتشار ثقافة الانتقام والثأر الفردي في عرقلة مساعي العدالة المؤسساتية، كما يتضح من ارتفاع وتيرة العمليات الانتقامية الفردية منذ سقوط النظام.
وتُعد التأثيرات النفسية لصدمات الحرب والانتهاكات عائقًا أمام الانخراط في مسارات المصالحة. لمواجهة هذه التحديات، تُقترح إستراتيجيات منها: تصميم حملات توعية شاملة حول أهمية العدالة الانتقالية كنهج بديل عن الانتقام، ضمان تمثيل جميع المكونات المجتمعية في مؤسسات العدالة الانتقالية، تعزيز الشفافية في جميع مراحل العملية، دعم المبادرات المجتمعية للمصالحة، وتطوير برامج التعافي النفسي والاجتماعي للضحايا والمتضررين.
لتجاوز التحديات المذكورة، يمكن اعتماد إستراتيجيات متكاملة تشمل؛ تبني نهج تدريجي ومرحلي في تطبيق العدالة الانتقالية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تلبية احتياجات الضحايا الأكثر تضررًا وبناء الثقة؛ وضع خطة وطنية شاملة للعدالة الانتقالية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، تحدد الأهداف والآليات والأطر الزمنية؛ تعزيز الملكية الوطنية لمسار العدالة الانتقالية مع الاستفادة من الخبرات الدولية، حيث يلعب السوريون الدور الرئيسي مع دعم وإشراف دولي؛ تطوير نظام مراقبة وتقييم فعال لرصد التقدم في تنفيذ برامج العدالة الانتقالية وإجراء التعديلات اللازمة؛ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مجال العدالة الانتقالية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
إضافة إلى ذلك، يمكن استخلاص الدروس من تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة، مع مراعاة خصوصية السياق السوري، وإتاحة مساحات آمنة للحوار والنقاش حول قضايا العدالة الانتقالية بين مختلف مكونات المجتمع. ويبقى الدعم الدولي ركيزة أساسية، مع ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الجهات الداعمة، وتخصيص موارد كافية لضمان استدامة برامج العدالة الانتقالية.
الخاتمة
تمثل العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لسوريا التي تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي بعد سقوط نظام استبدادي استمر لأكثر من نصف قرن. إنها ليست ترفًا أو خيارًا، بل هي شرط أساسي لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي خلّفت ملايين الضحايا والنازحين، وأحدثت دمارًا هائلًا في البنية المادية والاجتماعية للبلاد.
تكمن أهمية العدالة الانتقالية في كونها النهج الأكثر فاعلية للتعافي الشامل من آثار النزاع، وإرساء أسس راسخة لدولة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فعبر أركانها الأربعة – المحاسبة الجنائية، الحقيقة والمصالحة، جبر الضرر والتعويض، وإصلاح المؤسسات – يمكن للعدالة الانتقالية أن تسهم في تفكيك بنى الاستبداد والقمع، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، ومنع تكرار الانتهاكات، وتحقيق المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق نحو الاستقرار المستدام.
إن نجاح مسار العدالة الانتقالية يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية بتحقيق عدالة غير انتقامية، تركز على الإصلاح والتعافي بدلًا من الانتقام والثأر. يجب إدراك أن العدالة الانتقالية ليست وسيلة للتشفي من الخصوم، بل هي إطار متكامل يهدف إلى معالجة جذور النزاع وترميم النسيج الاجتماعي. هذا يستلزم نهجًا متوازنًا يجمع بين المحاسبة الضرورية للمسؤولين الرئيسين عن الانتهاكات من جهة، وتوفير فرص المصالحة والإدماج للأفراد الأقل تورطًا من جهة أخرى.
كما يتطلب الأمر مشاركة واسعة من الضحايا، المجتمع المدني، المؤسسات الوطنية، والمجتمع الدولي، في بناء رؤية مشتركة للعدالة تراعي احتياجات جميع السوريين وتطلعاتهم. فالعدالة الانتقالية ليست مسارًا يفرضه طرف على آخر، بل عملية تشاركية تستند إلى الحوار المفتوح والشفافية والشمولية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق السوري وتعقيداته.
إن الرؤية التي تقدمها الشبكة السورية لحقوق الإنسان للعدالة الانتقالية تمثل خارطة طريق نحو سوريا المستقبل: الوطن القائم على العدالة والكرامة وسيادة القانون. هذه سوريا الجديدة التي يتطلع إليها السوريون على اختلاف مشاربهم، دولة يعيش فيها المواطنون بكرامة وأمان، تصان حقوقهم وحرياتهم، وتُحترم خياراتهم.
سوريا التي تتجاوز ماضي الاستبداد والقمع لتبني مستقبلًا يقوم على المواطنة المتساوية، المشاركة السياسية، والتعددية الثقافية. ومع أن الطريق إلى سوريا هذه طويل وشاق ومليء بالتحديات، فإن وجود إرادة وطنية صلبة وإصرار على المضي قدمًا في مسار العدالة الانتقالية يجعل هذا الهدف قابلًا للتحقيق.
وفي نهاية المطاف، فإن العدالة الانتقالية ليست نهاية المسار، بل بداية عملية تحول طويلة نحو استعادة سوريا التي يستحقها أبناؤها: سوريا العدالة، والديمقراطية، والتنمية، والسلام.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حاصل على الماجستير في القانون الدولي، ومتوّج بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان عام
————————————
هيئة العدالة الانتقالية.. آمال ومخاوف من الانتقائية والعدالة المجتزأة/ محمد سليمان
19 مايو 2025
أصدرت الرئاسة السورية، السبت الفائت، مرسومًا يقضي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، تتولى ”كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية”. وقد أُسندت رئاسة الهيئة إلى عبد الباسط عبد اللطيف، مع منحه مهلة ثلاثين يومًا لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي.
يُعد المرسوم أول إجراء رسمي يُعلن في سياق العدالة الانتقالية، وقد فُسّر على نطاق واسع باعتباره خطوة أولى في هذا المسار، لكنه في الوقت نفسه أثار سلسلة من المخاوف والانتقادات القانونية والسياسية.
يرى المحامي عز الدين عز الدين أن هذا القرار كان متوقعًا، لكنه يُشدد على أن تشكيل الهيئة لا بد أن يستند إلى قانون خاص يحدد صلاحياتها المكانية والزمانية بشكل دقيق، وينظّم طبيعة عملها.
وأكد عز الدين، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن اللجنة يجب أن تكون مستقلة، نزيهة، شفافة، وأن تُجرى كل إجراءاتها بشكل علني، وفي مقدمتها الاستماع إلى إفادات الضحايا والشهود، معتبرًا أن ذلك يمثّل جوهر عمل أي هيئة للعدالة الانتقالية. وأضاف أنه يجب أن تضم أفرادًا يتمتعون بخبرة حقيقية، واطلاع واسع على تجارب العدالة الانتقالية في الدول الأخرى.
وأشار عز الدين إلى ضرورة أن تضم الهيئة مختصين بالقانون الجنائي الدولي، وخاصةً اتفاقية روما التي تُعنى بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى ذوي دراية بآليات جبر الضرر والتعويض. ويقترح أن تضم الهيئة أيضًا اقتصاديين قادرين على تدبير مصادر التمويل، وتوزيع المساعدات، ووضع برامج تعويض فعالة.
وأوضح أن الهيئة ليست جهة قضائية، وإنما لجنة قانونية تُصدر توصيات فقط، لا أحكامًا. وهذه التوصيات “قد تُحال إلى المحاكم لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، أو تُرفع إلى الوزارات المختصة، مثل وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.
وفيما يخص آليات الجبر والتعويض، أعاد عز الدين التأكيد على أن الاستقلالية تعد الشرط الجوهري لنجاح الهيئة، مشددًا على وجوب أن تكون مستقلة تمامًا عن الحكومة أو أي طرف آخر، إلى جانب توافر النزاهة والخبرة لدى أعضائها.
تساؤلات حول الحياد وضمانات غير كافية
من جانبه، يرى المحامي مصطفى كليب أن هذا المرسوم يمكن اعتباره بالفعل نقطة بداية لمسار العدالة الانتقالية، لكن الخطوة المنطقية، بحسب رأيه، كان يجب أن تبدأ بإصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية في سوريا، يُقر من خلال مجلس تشريعي من المفترض أن يتشكل لاحقًا، بحيث يوفّر الأساس القانوني الذي يحدد اختصاصات الهيئة، ويضمن آليات شفافة لاختيار أعضائها، ويكفل استقلالها، وحياد من يشغلون مواقعها، إلى جانب إنشاء منظومة رقابة على عملها.
ويؤكد كليب أن مجرد التأكيد على استقلال الهيئة المالي والإداري في نص المرسوم لا يكفي، ولا يُعد ضمانًا فعليًا لهذا الاستقلال، إذ إن التجربة السورية تُظهر أن القوانين دون إرادة تنفيذية صادقة قد تبقى “حبرًا على ورق”.
ويشير إلى أن أكثر ما يُؤخذ على المرسوم هو حصر اختصاص الهيئة بـ”الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد”. إذ إنه “على الرغم من أن الجرائم التي ارتكبها النظام تشكل الغالبية الساحقة من الانتهاكات في سوريا – وتصل بحسب التقديرات إلى ما بين 85% إلى 90% – إلا أن هذا لا يُبرر تجاهل ما ارتكبته أطراف أخرى بحق السوريين”.
وبرأيه، فإن العدالة لا يمكن أن تُجزأ، والضحايا لا يجوز أن يُصنّفوا حسب الجهة التي انتهكت حقوقهم، لأن ذلك يُفضي إلى “عدالة اجتزائية”، تُعيد إنتاج الظلم بدل معالجته. كما حذّر من أن هذه الصياغة تفتح الباب نحو نموذج من العدالة الانتقالية قائم على منطق “عدالة المنتصر”، كما حدث في تجارب فاشلة حول العالم.
ويضيف كليب أن هناك إشكالًا في المفهوم نفسه، متسائلًا: من يحدد ما يُعدّ “انتهاكًا جسيمًا”؟ فالعدالة الانتقالية لا تُعنى فقط بأشد الجرائم قسوة، رغم أن هذه تشكّل محورًا رئيسيًا، بل هي معنية بكل الانتهاكات على اختلاف طبيعتها، خاصةً عندما تُبنى العملية على مبدأ الشمول والاعتراف بالضحايا كافة.
ويُبدي قلقًا بالغًا من تعيين شخصية معروفة بانتمائها السابق إلى المكتب السياسي لأحد الفصائل العسكرية، في إشارة إلى عبد الباسط عبد اللطيف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير كثيرًا من التساؤلات حول مدى الالتزام بالحياد، وهو شرط أساسي في أي هيئة عدالة انتقالية ذات مصداقية.
ويتابع كليب بأن ما سيتضمنه النظام الداخلي المنتظر سيكون كاشفًا لكيفية إشراك المجتمع المدني، وعائلات الضحايا، في عمل الهيئة. ويُصر على أن العدالة الانتقالية ليست مسارًا تقنيًا تصممه الدولة من فوق، بل هي عملية مجتمعية تشاركية. ويؤكد على أنه من دون إشراك الضحايا الحقيقي “لا يمكن أن تكون هناك مصالحة صادقة، ولا يمكن للمجتمع أن يشعر أن الحقيقة تُصاغ لصالحه، لا لصالح السلطة”.
بين الفرصة والتوجّس
يبقى تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تطورًا بارزًا في السياق السوري، لكنه محفوف بالأسئلة الجوهرية: هل هي بالفعل بداية مسار وطني للإنصاف والمساءلة والمصالحة؟ أم أنها ستكون إطارًا شكليًا تُفرض فيه “العدالة من الأعلى” دون مشاركة مجتمعية فعلية؟
تجارب الشعوب التي سبقت سوريا إلى العدالة الانتقالية تُظهر بوضوح أنه لا عدالة دون اعتراف كامل بالضحايا، ولا مصالحة دون مساءلة حقيقية، ولا حقيقة تُحتكر من طرف واحد. فما ستقرره الأيام القادمة، وخاصةً ما سينص عليه النظام الداخلي، هو ما سيحسم ما إذا كانت هذه الهيئة بداية طريق، أم التفافًا جديدًا على آمال السوريين في العدالة.
تلفزيون سوريا
—————————–
تشكيل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سورية/ عدنان علي و حسام رستم
18 مايو 2025
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء يوم السبت، مرسومين رئاسيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في سورية. وجاء في مرسوم رئاسي: “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، واستناداً إلى الإعلان الدستوري، وحرصاً على الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية، وإنصاف ذويهم، يعلن عن تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين”.
وحدد المرسوم مهمة الهيئة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سورية، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم دعم قانوني وإنساني لعائلاتهم. وأوضح أن أمام الهيئة 30 يوماً لوضع نظامها الداخلي والانطلاق في عملها. وعين المرسوم محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة، مع منحها استقلالاً إدارياً ومالياً. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من ذوي المفقودين والمختفين قسراً، ومن منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية، للحكم الجديد في سورية، بالاهتمام بهذا الملف، نظراً إلى أنه يمس مئات آلاف العائلات السورية.
كما نص المرسوم الآخر على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وتعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية. وبموجب المرسوم، “يعين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان”. ومنح المرسوم الهيئة الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
محمد رضا جلخي.. أكاديمي سوري يرأس هيئة المفقودين
محمد رضا جلخي أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. وشغل عدة مناصب في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب. وعقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ”الأمانة السورية للتنمية”، التي تحول اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”. وعُين جلخي في 2 مارس/آذار الماضي في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور السوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.
وإلى جانب عضويته في مجلس أمناء “منظمة التنمية السورية”، يتولى جلخي عدة مناصب قيادية في قطاع التعليم العالي والتنمية، مثل أمين جامعة إدلب، وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ورئيس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية منذ 3 فبراير/شباط 2025، وهو باحث مشرف في المركز السوري للدراسات الاستراتيجية.
عبد الباسط عبد اللطيف.. المكلف بهيئة العدالة الانتقالية
أما المكلف بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، فهو من مواليد محافظة دير الزور 1963، وشغل منصب الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري التابع للمعارضة السياسية السورية. كان قد حصل على إجازة بالحقوق من جامعة حلب 1986، وهو نائب سابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية، ورئيس المكتب السياسي لفصيل “جيش أسود الشرقية”، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة 2018.
العربي الجديد
———————————
========================
لقاء الشرع-ترامب ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تحديث 19 أيار 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
—————————-
جولة ترامب الخليجية: مقاربة براغماتية يجسّدها مبدأ “أميركا أولاً“
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
الإثنين 2025/05/19
أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الفترة 13-16 أيار/ مايو 2025، أول جولة خارجية رسمية له منذ تولّيه الحكم في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، شملت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وركّزت على إبرام صفقات تجارية ضخمة معها؛ إذ رافقه العديد من كبار رجال الأعمال الأميركيين. وعلى الرغم من التركيز على الجانب الاقتصادي، فقد تناولت الزيارات قضايا أخرى مهمة، أبرزها قرار ترامب رفع العقوبات عن سورية، ولقاؤه برئيس الإدارة الانتقالية السورية أحمد الشرع، في الرياض. وقد عبّرت جولته واللقاءات الرفيعة المستوى التي أجراها في العواصم الخليجية الثلاث عن رغبة مشتركة في بناء شراكات تجارية وعسكرية وتكنولوجية كبرى. وبدا في بعض الحالات أنه لم يتحرر من خطاب الدعاية الانتخابية وركّز على شخصه وإنجازاته، وهاجم الإدارات السابقة وسياساتها.
الاتفاقات الموقّعة
تناولت الاتفاقات، التي وقّعتها الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الشركات الوطنية مع الدول الخليجية الثلاث، مجالات مختلفة في حقول الطاقة، والدفاع، والذكاء الصناعي والبنى التحتية، والاستثمار، والتعليم، والتجارة، والصحة. وبلغت القيمة الإجمالية المعلنة لهذه الصفقات أكثر من تريليونَي دولار أميركي، فقد تعهّدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، في حين وقّعت الإمارات مشاريع استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار تمتد على مدى عشر سنوات، أما قطر فتوصلت إلى اتفاقات للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار، بما في ذلك الطاقة. وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي رافقت توقيع الاتفاقات، خصوصاً من جانب ترامب، فإن بعض هذه الاتفاقات ليس جديداً، وقد أُثيرت شكوك حول قيمتها الفعلية وإمكانية تنفيذها، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط. ووفقاً لتقديرات وكالة “رويترز”، فإن القيمة الإجمالية للصفقات المتوقع تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة تقدّر بنحو 740 مليار دولار. ويُتوقع أن يستغرق تنفيذ بعضها، مثل طلب قطر شراء 210 طائرات من طراز “بوينغ”، وصفقة الأسلحة السعودية مع الولايات المتحدة البالغة قيمتها 142 مليار دولار، عقوداً من الزمن.
مقاربة براغماتية
انطلق ترامب في جولته الخليجية هذه من مبدأ “أميركا أولاً”، وهو شعار حملته الانتخابية الذي صار الموجِّه الرئيس للسياسة الخارجية لإدارته. وعبّر عن قناعته بأن إبرام الصفقات التجارية مع دول الخليج، وتدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها، أفضل من التورط في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط. وانطلاقاً من هذا التصوّر، حرص خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي في الرياض على إدانة المقاربة التدخّلية Interventionism التي لجأت إليها إدارات أميركية سابقة وقوى غربية أخرى بذريعة “بناء الدول”.
وبحسب ترامب، فإن “من يوصفون ببناة الدول دمّروا، في النهاية، دولاً أكثر من تلك التي بنوها، وكان التدخليون يتدخلون في مجتمعات معقدة لم يفهموها هم أنفسهم”. وفي هذا الإطار، حثّ شعوب المنطقة على “رسم مصائرها بطريقتها الخاصة”، من دون “محاضرات” من أحد حول “كيفية العيش”، وشدّد على أن “التحولات العظمى” التي تشهدها بعض الدول الخليجية لم تكن نتيجة “التدخلات الغربية، أو من يسمّون بناة الدول، أو المحافظين الجدد، أو المنظمات الليبرالية غير الربحية، مثل أولئك الذين أنفقوا تريليونات الدولارات من دون تطوير كابول وبغداد، وغيرهما كثير من المدن. بل إن ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة نفسها […] الذين طوروا بلدانهم ذات السيادة، وسعوا وراء رؤاهم الفريدة، ورسموا مصائرهم بأنفسهم”. ويضيف أن ثمّة اليوم “جيلاً جديداً من القادة يتجاوزون صراعات الماضي القديمة وانقساماته البالية، ويصنعون مستقبلاً يُعرَّف فيه الشرق الأوسط بالتجارة، لا بالفوضى؛ ويُصدِّر التكنولوجيا، لا الإرهاب”.
تمثل مقاربة ترامب التعاقدية، البعيدة عن مزاعم نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، قطيعة كاملة مع السياسات التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي شهدت خلالها علاقات واشنطن مع دول الخليج نوعاً من الفتور. لكن التغيير الذي طرأ على المقاربة الأميركية نحو دول الخليج، والشرق الأوسط عموماً، في إدارة ترامب الثانية لم يقتصر على التباين مع إدارة بايدن، بل يشمل أيضاً اختلافات واضحة مقارنةً بإدارته الأولى. ففي حين اقتصرت زيارة ترامب الأولى إلى المنطقة عام 2017 على السعودية، التي كانت حينئذ أول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة، فقد شملت زيارته الثانية قطر والإمارات أيضاً. ويُسجَّل كذلك أنه تجاهل زيارة إسرائيل في جولته الأخيرة، بخلاف جولته الأولى التي انتقل فيها مباشرة من الرياض إلى تل أبيب، وهو ما فعله أيضاً الرئيس بايدن خلال زيارته المنطقة عام 2022.
وعلى الرغم من أن ترامب حثّ السعودية على الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل، فإنه لم يجعل من ذلك أولوية، ولم يشترط ربط أيٍّ من الاتفاقات الاقتصادية أو الصفقات العسكرية بذلك. وتشير تقارير وتسريبات متعددة إلى وجود تباين في الأولويات، وربما توتر مكتوم بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، إذ إن انطلاق ترامب من مقاربة “أميركا أولاً” ولّد حالة من “الإحباط” لدى نتنياهو إزاء تفاعلات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يعرب مسؤولون في إدارة ترامب، في أحاديث خاصة، عن استيائهم من نتنياهو بسبب إفشاله مساعي الرئيس للوفاء بوعدٍ كان قد قطعه في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في قطاع غزة. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن خلافات استراتيجية بين ترامب ونتنياهو، أو عن اختلاف مبدئي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة؛ فترامب، وإن كان قادراً على وقف مخططات نتنياهو العدوانية في غزة، لا يُبدي رغبة في ذلك، ولا يعدّه أولوية. وهو لا يختلف مع نتنياهو في الهدف المتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، لكنه يرفض أن يُملي عليه نتنياهو سياسات الولايات المتحدة الإقليمية برمّتها، ويفضّل في الوقت ذاته تجنّب الدخول في حرب مع إيران. أما بخصوص سياسات ترامب في الخليج، وعدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان وغيرها، فلا يسجَّل خلاف بشأنها مع نتنياهو، باستثناء ما قد يكون من تحفّظ عن تقارب ترامب مع القيادة القطرية، التي يقود ضدها اللوبي الإسرائيلي ونتنياهو حملةً في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة التي ألحّت على وقف الحرب على غزة في المحادثات مع ترامب خلال زيارته الخليجية.
ويبدو أن ترامب عازم على المضي قُدماً في أجندته التي تركّز على الصفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها، حتى لو تطلّب ذلك تجاوز إسرائيل. ويندرج ضمن هذا التوجه انخراط إدارته في المفاوضات النووية مع إيران، رغم معارضة نتنياهو لها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، والذي لم يتضمن اشتراطات بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو قصف إسرائيل بالصواريخ. كذلك، خاضت إدارته مفاوضات مع حركة حماس، بوساطة قطرية ناجحة، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، من دون التنسيق مع إسرائيل، الأمر الذي أدى بنتنياهو إلى تصعيد وتيرة قصف غزة بعد إطلاق سراحه. وأخيراً، إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا ودعوته إلى تطبيع العلاقات مع دمشق تحت رئاسة الشرع الذي تتهمه إسرائيل بأنه “جهاديّ”. وعلى الرغم من أن ترامب نفى وجود توتر في العلاقة مع إسرائيل، وتأكيد نتنياهو من جانبه على متانة هذه العلاقة، مستنداً إلى أن ترامب لم يضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في غزة خلال زيارته المنطقة، أو إدخال المساعدات الإنسانية إليها كما وعد في حال إطلاق حماس سراح عيدان، فإن ذلك كله لم يُخفِ وجود نوع من التوتر الكامن في علاقتهما. ولكنه ليس توترًا سياسيًا أو استراتيجيًا، بل يُعزى إلى توقعات مفرطة لدى نتنياهو بشأن ما كان يأمل أن يفعله ترامب. وهو ما تنشغل به الصحافة الإسرائيلية، ولا سيما الأصوات الناقدة لنتنياهو التي تضخّم الخلاف، متجاهلة أن الولايات المتحدة قد رفعت جميع القيود على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وأطلقت يد نتنياهو ووزير أمنه في غزة.
العلاقة مع سوريا
انعكست الطبيعة البراغماتية والتعاقدية في شخصية ترامب أيضاً في قراره المفاجئ، حتى لبعض مسؤولي إدارته، برفع العقوبات عن سوريا ولقائه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، في 14 أيار/ مايو، بوساطة تركية – سعودية. وقد برّر ترامب قراره باعتباره دعماً “لحكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار في البلاد وحفظ السلام”، واصفاً العقوبات بأنها “وحشية ومعوِّقة، وحان الوقت لتنهض سوريا”. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تصنّف الشرع “إرهابياً”، كما تصنف هيئة تحرير الشام التي يتزعمها منظمة إرهابية، فإن عوامل متعددة ساهمت في إقناع ترامب بلقائه، من أبرزها دور الهيئة في إسقاط نظام الأسد، وإخراج إيران من سوريا، إضافة إلى علاقات الشرع الجيدة مع السعودية والإمارات، والدعم التركي، واستعداده للتفاوض مع إسرائيل والتعاون في محاربة الإرهاب.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى وجود معسكرين في إدارة ترامب فيما يتعلق بمقاربة الملف السوري. المعسكر الأول الذي يمثّله مجلس الأمن القومي الأميركي، يتبنّى موقف الحذر ويدعو إلى الانتظار وعدم الوثوق بالشرع وحكومته استنادًا إلى تاريخه، أما المعسكر الثاني الذي تمثّله وزارة الخارجية، فيرى ضرورة المسارعة إلى ملء الفراغ الذي خلّفه سقوط الأسد، منعًا لعودة روسيا وإيران إلى بناء نفوذ جديد في سوريا. ويعدّ لقاء ترامب بالشرع، وإعلان رفع العقوبات عن سوريا، بمنزلة انتصار مقاربة المعسكر الثاني الذي سهّل الشرع مهمته من خلال سلسلة من الخطوات أقدم عليها كي يحظى بدعم واشنطن لإعادة إعمار سوريا، شملت اعتقال مسلحين أجانب، والتواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، وإبداء الاستعداد لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالقيام بالعمل في سوريا. وفي بيان رسمي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع المساعدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، و”تولّي مسؤولية” مراكز احتجاز عناصره في شمال شرق سوريا، إضافة إلى ترحيل فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا، وحثّه على التطبيع مع إسرائيل. ولا شك في أن عملية رفع العقوبات لن تكون فورية، إذ من المرجّح أن تتحول بعض المطالب الأميركية إلى شروط وضغوط تفاوضية، ولكن رفع بعضها على الأقل بمرسوم رئاسي، ولا سيما تلك التي تمنع التحويلات المالية، سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري.
العامل الصيني
ثمّة عامل آخر شديد الأهمية يؤكد البعد البراغماتي والعملي في مقاربة ترامب لجولته في المنطقة وتركيزه على الصفقات التجارية والاستثمار، ويتعلق بالمنافسة التجارية والتكنولوجية مع الصين، وتحديد صاحب اليد العليا في المنافسة على كسب النفوذ داخل الخليج. وتبرز في هذا السياق مسألة مدى استعداد إدارة ترامب لرفع القيود المفروضة على بيع مئات الآلاف من أشباه الموصلات المتقدمة (الرقائق الإلكترونية) إلى الإمارات والسعودية. ومن هذا المنطلق، أصدر ترامب قراراً بإلغاء “قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي” التي وضعتها إدارة بايدن، وفرضت بموجبها قيوداً على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى دول شملت الإمارات والسعودية، إضافة إلى الهند والمكسيك وإسرائيل وبولندا ودول أخرى خشية “تسريبها” إلى الدول المعادية، وخاصة الصين. وتدرس إدارة ترامب حالياً صفقة محتملة لتوريد مئات الآلاف من أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية تطوراً إلى شركة G42، وهي شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كانت قد قطعت صِلاتها بالشركاء الصينيين تمهيداً للدخول في شراكة جديدة مع الشركات الأميركية. كما أعلن البيت الأبيض عن صفقات أخرى مع السعودية تضمنت التزاماً من شركة Humain، وهي شركة ذكاء اصطناعي في الرياض مملوكة للدولة، ببناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي باستخدام مئات الآلاف من شرائح Nvidia الأميركية المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتؤكد تقارير أميركية أن دخول إدارة ترامب في مفاوضات مع الإمارات والسعودية حول الشراكة في تكنولوجيا الذكاء الصناعي يشير إلى ترجيح الكفّة لصالح الرأي القائل إن تعزيز التفوق التجاري والتكنولوجي الأميركي على الصين يتطلب مثل هذه الشراكة والاستثمارات. ويمثّل هذا التوجه الموقف الذي تتبنّاه الرياض وأبو ظبي، اللتان تؤكدان أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لشراكتهما، وتطالب بتقييد علاقاتهما التكنولوجية المتقدمة مع الصين في سياق سباق التسلح العالمي في الذكاء الاصطناعي، فإن على واشنطن القيام بدورها في رفع القيود المفروضة على تقنياتها. وفي المقابل، لا يزال هناك تيار داخل إدارة ترامب يرى أن شراكةً مثل هذه تحمل مخاطر جمّة حول إمكانية تسرب التقنيات الحيوية إلى الصين.
خاتمة
يمنح تماسك الحزب الجمهوري وتوحده خلف الرئيس ترامب قوة كبيرة له في رسم السياسة الخارجية، من دون الالتفات إلى القيود الداخلية التي كانت تحدّ من قدرة رؤساء سابقين على الحركة. ويشمل ذلك قرارات بارزة منها تخلّيه عن الدعم المطلق لأوكرانيا، وتأييده المحادثات المباشرة مع إيران حول برنامجها النووي. بل إن نتنياهو الذي لم يتردد في تحدي الرئيس الأسبق باراك أوباما وكذلك بايدن في ملف المفاوضات النووية مع إيران وملفات أخرى، التزم الصمت إزاء قرار ترامب استئناف المفاوضات مع إيران، وتفاوضه مرتين مع حركة حماس من دون تنسيق مع إسرائيل، وتوصله إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين، واعترافه لاحقًا بحكومة الشرع في سورية. وتجسد هذه الخطوات السابقة مجتمعة، إلى جانب جولته الخليجية والصفقات التي عقدها خلالها، مقاربة ترامب لشعار “أميركا أولاً”. ومع ذلك، لا ينبغي أن يحجب هذا التوجه بُعدًا آخر يتمثّل في الطابع الشخصي المحتمل لتحركات ترامب ومكاسبه، خاصة في ظل تركيزه على الصفقات التجارية والاستثمارية، بدلًا من المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالمنطقة باتت موطنًا للعديد من المشاريع الجديدة لشركات عائلة ترامب، بما في ذلك أبراج ترامب السكنية في دبي وجدة. كما قدّم صندوق استثماري إماراتي دعمًا لعملة ترامب الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن دول الخليج تنظر إلى الطابع التعاقدي والبراغماتي لترامب باعتباره فرصة لها لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الإشارة ضرورية إلى أن زيارة ترامب للمنطقة لم تسفر عن أيّ انفراجة في ملف قطاع غزة؛ فعلى الرغم من استيائه المعلن من التصعيد العسكري الإسرائيلي هناك، فإنه لم يتخذ أيّ خطوات فعلية للضغط على نتنياهو لوقفه.
————————————
لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟/ عبد الرحمن الراشد
18 أيار 2025
كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ الاختلاف حول رفع العقوبات من عدمِه محتدمٌ داخل الإدارة الأميركية نفسها.
لهذا جاءَ اللجوء مباشرة إلى الرئيس دونالد ترمب، وعبر حليفٍ موثوق هو السعودية، فكانَ أقصرَ الطرق. ويتطلَّب جهوداً مكملة من قبل حكومة الشرع التي عليها أولاً أنْ تقدّمَ المزيدَ من التطمينات باحتواء القوى المحلية، وحمايةِ الأقليات، وبذلِ المزيد ضد الفكر المتطرف الذي سيهدّد سلطةَ أحمد الشرع نفسَها ما لم تحاربه.
وجهة نظر الذين يعارضون رفعَ العقوبات ترتكز على أنَّ النظامَ الجديدَ هو تنظيمٌ مُصنفٌ إرهابياً، وعليه أن يثبتَ العكس. وهناك مطالب اشترطتها الحكومة الأميركية، خمسة منها أشار إليها ترمب بعد لقائه الشرع. أولها إخراج المقاتلين الأجانب، والثاني المساعدة في محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والثالث إبعاد التنظيمات الفلسطينية، وتولي إدارة مراكز احتجاز مقاتلي «داعش»، والخامس، التوصل إلى علاقة مع إسرائيل.
لكن قبل الخوض في إمكانية تنفيذ هذه الشروط على حكومة الشرع، من المناسب الترافع حول لماذا يستحق النظام السوري الجديد أن يعطى «الفرصة»، كما سماها ترمب.
أولاً الشرع ونظامه في سوريا هو حقيقة وأمرٌ واقع على الجميع التعامل معه، وهو الحال مع أنظمة أخرى في المنطقة فيها ميليشيات وتتعاون معها. والواقع يقول أن تغيير النظام الجديد ليس مطروحاً، والعودة للحرب مرفوضة، والشعب السوري يستحق أن يخرج من النفق المظلم.
ثانياً، إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا نتيجة ذات قيمة كبيرة غيَّرت مسار تاريخ المنطقة ومستقبلها وليس فقط سوريا. وحرَّرت الشمال العربي، سوريا ولبنان وفلسطين. ولولا التغول الإيراني في دمشق ونتائجه الوخيمة على المنطقة، ربما ما تغيَّر الوضع القديم. إضعاف النظام الجديد سيعيد إيران سواء نتيجة الفوضى المحتملة أو ضعف دمشق.
الثالث، أنَّ إعادة العقوبات أسهل من رفعها، في حال اتضح أنَّ دمشق لم تفِ بوعودها. أما العكس، عدم رفعها، سيشجّع على التمرد والفوضى، أو دفع دمشق نحو محاورَ أخرى تتسبَّب في المزيد من التوتر الإقليمي.
الرابع، إسرائيل اليوم هي ضابط الإيقاع في تلك المنطقة. ولا يمكن مقارنة دمشق بكابل وحكومة الشرع بطالبان التي لا يجاورها من يوازنها. دمشق في مرمى القوات الإسرائيلية التي أصبحت تتمتعَّ بهيمنة واسعة وترسم لجيرانها خطوطاً حمراء تشمل أنواع السلاح والمسافات والمواقع، وبالتالي إسرائيل أصبحت الضامن لاعتباراتها هي. ولبنان اليوم نموذجٌ تحت الهندسة الأمنية الإسرائيلية.
بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، والعودة الإيرانية فإنَّ خيار المجتمع الدولي والإقليمي الأسلم هو إعطاء دمشق ما تحتاجه لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقرار سوريا وأمن المنطقة معاً. سوريا تقع في قلب منطقة الأزمة، وفي حال تركها ستهددها الفوضى ونتائجها الوخيمة مؤكدة، ليبقى الخيار الأهون منحها الفرصة مع ما قد تحمله من «مغامرة» يمكن التعامل معها في أسوأ الأحوال.
التعاون العربي مع دمشق عن قرب اليوم، خير من محاولة تدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، فالأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين 7 ديسمبر الماضي وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة الشرع أدلةً على انفتاحها واستعدادها للتعاون، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك.
المطالب الأميركية تبدو محرجة في العلن، إنَّما تصب في صالح دمشق في الأخير. فحظر المقاتلين الأجانب مطلوب من كل الحكومات، ومحاربة الإرهاب ملزم دولياً. أما التنظيمات الفلسطينية هناك، فهي في الحقيقة ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق، كانَ يستخدمها في لبنان ضد الدول العربية، باستثناء «حماس»، فقد كانت ليست سورية.
المتوقع أنَّ الشرع سيخرج كل هذه الجماعات، برغبته، كما أخرجها الأردن من قبل، ويحاول لبنان التخلّصَ من ما تبقى منها.
ماذا عن شرط الانخراط في اتفاق مع اسرائيل،؟ للتذكير فإن الشرع ووزراءه سبقوا ترمب بالحديث مرات عن استعدادهم لذلك في إطار مشروع سلام عربي. ومهما كانت بقية المخاوف، التي لم استطرد فيها، فإن المنطقة قادرة على الاستيعاب والتغيير، ويبقى هذا خيراً من ترك البلاد تقع فريسةً للفوضى الأخطر على الجميع.
ونتوقع أن تتفهم حكومة دمشق وتبتعد عن التجاذبات الإقليمية والدولية المعقدة. والحق يقال أنَّ الرئيس الشرع كان يلمح في كثير من تصريحاته على انفتاحه على الجميع ورغبته في التركيز على التنمية والتطوير.
الشرق الأوسط
——————————
هل يستطيع الشرع تحقيق مطالب ترامب؟/ عبد الرحمن الحاج
18/5/2025
عندما رجعت المبعوثة الأميركية باربرا ليف (مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط) من لقاء استكشافي للقيادة الجديدة بدمشق في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024 قالت إنها ترى في الشرع شخصًا “براغماتيًا”، وإنها سمعت منه تصريحات “عملية ومعتدلة للغاية”، وخلصت إلى أن السوريين الآن “لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم”، وكانت ليف قد أبلغت الشرعَ بقرار واشنطن إلغاء المكافأة المرصودة (10 ملايين دولار،) والتي عرضتها واشنطن سابقًا مقابل الحصول على معلومات تؤدّي للقبض عليه.
وفي اليوم التالي لتولّي ترامب رئاسة الولايات المتحدة أرسل الرئيس أحمد الشرع رسالة تهنئة “باسم قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية”، تضمّنت رسالة التهنئة توددًا ملحوظًا، حيث قال فيها عن ترامب “إنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”، وإنه (الشرع) يتطلع إلى “تحسين العلاقات بين البلدين بناء على الحوار والتفاهم”، و”إقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين”، ولم ترد الإدارة الأميركية على الرسالة، وأظهرت بعض التحفظ والغموض في التعامل مع الشرع الذي كان قد أصبح رئيسًا للمرحلة الانتقالية ابتداءً من 29 يناير/ كانون الثاني 2025 بموجب تفويض القيادة العسكرية.
يرجع هذا التحفظ إلى عدم تبلور تصور واضح لإدارة ترامب عن الإستراتيجية التي ستتبعها في سوريا، وتأثرها بوجهة النظر الإسرائيلية، وهو توجه كان يقوده مسؤولون في مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى مديرة المخابرات تولسي غابارد، ومدير قسم مكافحة الإرهاب سباستيان كورغا، والذي يرفض أي انخراط مع الحكم السوري الجديد، وينظر إلى الإدارة في سوريا من خلال التصنيف الدولي لـ”هيئة تحرير الشام” وقياداتها، ومن خلال تاريخهم في الانخراط في منظمات جهادية.
الشروط الثمانية
على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/ آذار الماضي، سلّمت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى، قائمة بثمانية شروط/ مطالب إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع شخصي، للبدء في تخفيف العقوبات، وإعطاء رخصة لمدة عامين، تتضمن هذه الشروط “إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية”، والموافقة على قيام أميركا باستهداف أي شخص تعتبره واشنطن تهديدًا لأمنها، وتصنيف كل من “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني تنظيمَين إرهابيين، والتعهد بالتعاون مع المنظمة الدولية لنزع سلاح الدمار الشامل لتدمير ما تبقى من مخزون السلاح الكيميائي، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الجيش، والتزام علني بمحاربة تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي، وتشكيل لجنة للبحث عن المفقودين الأميركيين في سوريا، والتعهّد بتسلم عائلات تنظيم الدولة من معسكر الهول الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
مثلت الشروط بداية انخراط أميركي مع الإدارة الجديدة، وهو توجه كان يدعمه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بناء على المكاسب التي يحققها هذا الانخراط في تثبيت خسائر إيران الإستراتيجية التي تحقَّقت، وتعزيز استقرار الشرق الأوسط، وقد عكست الشروط ذلك التوجّه بوضوح.
كانت معظم المطالب الأميركية الثمانية تتلاقى بطبيعة الحال مع مساعي دمشق لتحقيق الاستقرار، باستثناء مطلبَين: حظر الفصائل الفلسطينية وتولي أجانب مناصب قيادية في الجيش، ولم يتأخّر الرد، فقد أرسلت الخارجية السورية رسالة موقّعة من وزير الخارجية الشيباني في 14 أبريل/ نيسان تضمّنت الوثيقة إبلاغًا بأن دمشق شكّلت لجنة خاصة لـ”مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية”، مع تأكيد أن الدولة السورية “لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها”، وتعهدًا بعدم السماح باستهداف إسرائيل من خلال الأراضي السورية، وتوضيحات بشأن التقدم في ملف الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأظهر الرد تقدمًا محدودًا في تلبية مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع القيادية، لكن بحسب الوثيقة تعهدت دمشق بعدم منح مزيد من الرتب والمناصب القيادية للأجانب في الجيش، وتحفظًا يتعلق بقضايا سيادية مثل منح الولايات المتحدة صلاحيات تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب، وحرية تحرك قوات التحالف داخل الأراضي السورية.
وعلى الرغم من التحفظات كانت الرسالة بمنزلة رد إيجابي على المطالب الأميركية، نُظر إليه في الولايات المتحدة على أنه تقدم في مساعي الحكومة في دمشق لرفع العقوبات، وكانت الرسالة الجوابية قد أرسلت قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي، تمهيدًا لزيارة مهمة للشيباني إلى نيويورك، مع وزراء آخرين، التقى فيها بمسؤولين أميركيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.
مطالب ترامب
وفي سياق المساعي الضخمة المبذولة من الحلفاء الإقليميين والدوليين لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا مهّدت الرسالة للتعاطي الإيجابي مع دمشق، ومع وصول تلك الجهود إلى نهايتها، أعلن ترامب رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، في 13 مايو/ أيار الجاري، وشكل هذا الإعلان حدثًا كبيرًا تلقّاه السوريون بسعادة بالغة.
وفي اليوم التالي لإعلان ترامب رفع العقوبات التقى الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أونلاين)، وبحسب بيان البيت الأبيض فإن ترامب الذي بدا معجبًا بالرئيس الشرع قدم 5 مطالب، بحسب ما ورد في وكالة رويترز:
الانضمام إلى اتفاقية أبراهام مع إسرائيل.
مطالبة جميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا.
ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين.
مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم الدولة.
تحمل مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.
من الواضح أن جزءًا من المطالب الأميركية تغيّر بعض بنوده وأصبح أكثر جرأة، فقد كان على الأميركيين على ما يبدو أن يحصلوا على بعض تعهدات من الرئيس الشرع بخصوص قضايا إستراتيجية تهم الأميركيين والإسرائيليين مقابل الخطوة الأميركية الكبيرة في رفع العقوبات والاعتراف بالحكومة الانتقالية في دمشق، كما أن جزءًا من هذه المطالب الجديدة يرجع إلى التحفظات، أو الخطوات غير الحاسمة التي اتخذتها دمشق بخصوص الفصائل الفلسطينية، وجزءًا آخر يرجع إلى ضمان عدم عودة إيران إلى المنطقة ومحاربة الإرهاب، والجزء الثالث والأخطر يتعلق بإسرائيل وعقد اتفاق سلام معها.
إخراج الفصائل الفلسطينية
يُظهر الطرح الأميركي تشددًا غير مسبوق بخصوص الفصائل الفلسطينية، المقصود بدرجة رئيسية هنا حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والانتقال من حظرها إلى إخراجها من سوريا، ويبدو أن تشكيل لجنة مختصة بمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية، وضمان عدم استهدافها إسرائيل من الأراضي السورية لم يكن كافيًا، تريد الولايات المتحدة ضمان عدم وجود أي فصيل فلسطيني على الأراضي السورية، وهذا بطبيعة الحال يقصد به قيادات الفصائل السياسية والعسكرية.
يواجه الشرع، الذي يسعى لأن يظهر التزامًا يعزز الثقة به في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، قرارًا صعبًا، وصعوبة هذا القرار تكمن في أن القضية الفلسطينية تمثل جزءًا من وجدان الشعب السوري، ووجدان الشرع نفسه، الذي كرر ذكر القضية الفلسطينية في معظم مقابلاته قبل التحرير، إضافة إلى أنها قضية عربية وإسلامية وعالمية، أي أنها معززة بطبقات من الوجدان الإنساني، ومن الصعب الفصل بين القضية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
الخيارات المتاحة للشرع محدودة بخصوص التعامل مع الفصائل الفلسطينية، وسيتعين عليه التعاون مع الحلفاء الإقليميين مرة أخرى لتفادي تنفيذ سيناريو سيئ لهذا المطلب، ومن المحتمل أن تقوم تركيا وقطر بدور مهم في هذا السياق، في استضافة قيادات الفصائل التي أغلقت مكاتبها في دمشق بطبيعة الحال، وستمثل هذه الاستضافة مخرجًا معقولًا يحفظ الكرامة لهم وللقيادة السورية.
معظم قادة هذه الفصائل غادروا دمشق، خلال الأشهر الفائتة، إما بسبب القصف الإسرائيلي، أو بسبب الضغوط ومحاولتهم ألا يشكلوا عبئًا محرجًا لدمشق التي تحاول النهوض من تحت الركام، وبكل الأحوال فإن لدى هذه الفصائل مكاتبها في لبنان، ولا تزال تتمتع ببعض الحرية في نشاطها هناك، ما يجعل لدى هذه الفصائل هامشًا للمناورة يسمح لها بالبقاء قريبة من فلسطين.
الانضمام إلى اتفاقية أبراهام
كان أول المطالب المذكورة في بيان البيت الأبيض هو طلب توقيع اتفاقية أبراهام مع إسرائيل، وهي “معاهدة للسلام والتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة مع إسرائيل، واتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.
وعلى الرغم من أن الشرع تحدث في اللقاء، كما أشار بيان البيت الأبيض، عن الالتزام باتفاق الهدنة (فض الاشتباك) عام 1974، فإن ترامب ألحّ على الشرع، كما يوضح ترامب نفسه في لقاء صحفي على متن طائرته، بالتعهد بتوقيع اتفاقية أبراهام مع إسرائيل، فكان رد الشرع بالإيجاب.
ثمة العديد من العقبات تحول دون توقيع اتفاق سلام جديد مع إسرائيل، فمن جهة لا يملك الشرع في المرحلة الانتقالية صلاحية عقد مثل هذه الاتفاقية، فهو يملك صلاحيات محدودة، فهو رئيس غير منتخب، كما يتطلب مثل هذا القرار وجود برلمان منتخب، ومن جهة أخرى يجب معالجة وضع الأراضي المحتلة، لا يمتلك الشرع الآن صلاحية التنازل عنها، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتدادات وإضعاف الدعم الشعبي الذي يتمتع به، فقد مثلت قضية الجولان واحدة من القضايا الرئيسية للطعن في شرعية نظام الأسد السابق.
بكل الأحوال الالتزام بتوقيع اتفاقية أبراهام غير محدد الأجل، ويتطلب إذا ما أراد الشرع تنفيذه ضمان استقرار البلاد، والحفاظ على الشرعية التي حصدها بإنجازاته المتتالية، وصحيح أن السياسي في بعض اللحظات مضطر للذهاب إلى خيارات قاسية، إلا أن الالتزام بتوقيع الاتفاق غير المحدد بزمان يتيح للشرع هامشًا واسعًا للمناورة، ويدرك الأميركان أن هذا ليس أمرًا يسيرًا يمكن أن يتم بين يوم وليلة حتى لو أراد الشرع ذلك، فثمة عوامل موضوعية تجعل من الواقعي تمامًا اعتبار هذا الالتزام مجرد توجه عام في الوقت الراهن، سيكون من نتائجه “اتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.
ومن المحتمل أن يكون حرص ترامب على أخذ التزام من قبل الشرع بالانضمام إلى اتفاقية أبراهام هو مستند أيضًا لضبط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ومنع الإسرائيليين من القصف المستمر وغير المبرر في الأراضي السورية، ووقف تهديداتهم، فقد كان هذا واحدًا من المطالب السورية والتي كررها الحلفاء مع الأميركيين الذين يملكون وحدهم القدرة على لجم نتنياهو، خصوصًا مع ظهور تباين في موقف الإدارة الأميركية مع نتنياهو وحكومته.
المجموعات المصنفة تحت لوائح الإرهاب
طلب ترامب “مطالبة جميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا”، والمقصود بذلك جماعات وشخصيات غير سورية مصنفة إرهابية، ينطبق ذلك على تنظيم الدولة، وعلى الفصائل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والجماعات الجهادية الأخرى المندرجة في القوائم الأميركية للإرهاب.
ومن الواضح أن معظم ما هو مصنف من الجماعات الأجنبية في سوريا في قوائم الإرهاب هم جهات معادية للسوريين عمومًا، ومعادية بشكل خاص للقيادة السورية الجديدة، وهي تبذل أقصى الجهود لمنعها من التواجد في سوريا، وأعني بذلك تنظيم الدولة والمليشيات الشيعية، والحرس الثوري، وحزب الله، ولكن المشكلة تتعلق بأفراد محدودين ومجموعات صغيرة متواجدة في سوريا، وبعض هؤلاء لعب دورًا في العمليات العسكرية ضد نظام الأسد.
ليس كل المقاتلين الأجانب البالغ عددهم نحو 2500 في هيئة تحرير الشام مصنفين تحت القوائم كإرهابيين، فمعظمهم من قومية الإيغور الصينية (التركستان)، وقد تم إزالتهم من التصنيف عام 2020، وعلى الأغلب سيتم تجنيس هؤلاء وتوطينهم ودمجهم بالمجتمع السوري، خصوصًا أن الكثيرين منهم خلال العقد المنصرم أقاموا علاقات زواج مع السوريين وصار لديهم عائلات، ولديهم إسهامات مهمة في العمليات العسكرية ضد نظام الأسد، وبشكل خاص في معركة ردع العدوان أو معركة التحرير.
من الصعب على الشرع بدون شك التخلي عن رفاق الدرب، يتعلق الأمر بشكل خاص ببعض المقاتلين العرب والأجانب، لكن يمكنه أن يدفعهم للتواري عن المشهد، ويأخذ تعهدًا بالتزامهم بعدم النشاط في سوريا أو اتخاذ الأراضي السورية منصة لاستهداف أنظمة بلدانهم، في حين يمكنه الطلب من التنظيمات التي صنفت كتنظيمات إرهابية المغادرة، إذا كان ذلك ممكنًا، مثل الشيشان، ومعظم هذه التنظيمات المصنفة لم تكن على وفاق مع الشرع، ما يسهل له إمكانية طلب المغادرة منها.
كما يمكنه تخيير بعض الشخصيات بين اللجوء السياسي ومنعهم من النشاط السياسي انطلاقًا من الأراضي السورية، أو المغادرة، قد يكون هذا مقبولًا للأميركيين، الذين يدركون أن التطبيق الحرفي ليس دائمًا ممكنًا في السياسة، ويظهر إسقاط مطلب عدم تولي القادة الأجانب مناصب قيادية في الجيش نوعًا من الرضا الأميركي عن طريقة معالجة الأمر من قبل الشرع، التي شُرحت في رسالة الخارجية للرد على المطالب الثمانية.
تنظيم الدولة وقسَد
البند الخامس المكرر في المطالب الثمانية ومطالب ترامب والمتضمن تعهدًا بـ”تحمل مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا” يشير إلى تأكيد انسحاب الجيش الأميركي من شمال شرق سوريا، وتفكيك الإدارة الذاتية، ويتطلب هذا التعهد القيام بجملة إجراءات، منها التفاهم مع قيادة قسَد، وهو أمر حدث في اتفاق المبادئ الذي وُقّع برعاية أميركية في القصر الجمهوري بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع، والبدء بتنفيذ الترتيبات الميدانية على الأرض، وضمان تسلم مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وبشكل خاص المؤسسات الحيوية (النفط والسدود)، وهو أمر جارٍ على الأرض، وإن كان يلقى ممانعة وعرقلة من قبل قيادات قسَد، ولربما يكون لحل حزب العمال الكردستاني نفسَه أثر قوي في تسريع تنفيذ الاتفاق وتسلم السلطة المركزية بدمشق جميع المرافق والمؤسسات، وبسط نفوذها على جميع الأراضي السورية، بما في ذلك مراكز احتجاز أسر مقاتلي تنظيم الدولة في مخيم الهول وأماكن أخرى.
كل الظروف الآن باتت مهيأة لدمشق لتحقيق ذلك، والتأكيد على المطلب الخاص بتسلم مسؤولية مراكز الاحتجاز يتضمن رسالة لقسد من جهة، بأن الأمر منتهٍ، ويجب تنفيذ الاتفاق، ومن جهة أخرى التأكيد على مسؤولية الإدارة السورية في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعني التعامل مع دمشق كشريك في هذا الملف، ما يجعل مطلب التفويض بالضربات العسكرية لقوات التحالف بدون موافقة دمشق غير وارد مرة أخرى، ويبدو أن الإدارة الأميركية تفهّمت الحساسية وتأثيره على استقرار الدولة وتعزيز السلطة المركزية التي يعني استقرارها استقرار الشرق الأوسط كله.
الآفاق
كما هو ملاحظ فإنّ بعض هذه المطالب قابل للتنفيذ الفوري، لكن معظم المطالب الأخرى إستراتيجية طويلة الأمد، يحتاج تنفيذها من جهة وقتًا طويلًا، ومن جهة أخرى يجب التعامل معها بطريقة نسبية تسمح بتنفيذها على مراحل وبطرق مختلفة تحقق الهدف، دون أن يعني ذلك تنفيذًا حرفيًا، غير أن الأهم بالنسبة للإدارة الأميركية أن ترى في دمشق التزامًا ملحوظًا بما تعهّدت به يسمح بتحوّل الشرع إلى حليف موثوق.
وبالنسبة لدمشق فإن الالتزام في حدود الممكن، يعزز فرص استقرار سوريا وانتقالها للحلف الغربي والتخلص من الإرث البائس للنظام السابق، ويمكن أن يستفاد منها لتعزيز الاعتدال ومواجهة التشدد في الجناح المتشدد في هيئة تحرير الشام المنحلة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
أكاديمي وباحث متخصص في الحركات الإسلامية
الجزيرة
———————————-
حين يلتقي الشعبوي بالجهادي: صفقة تتجاوز التوقعات/ وائل السواح
19.05.2025
شكّل لقاء ترامب والشرع لحظة مفصلية لا تخص سوريا وحدها، بل تعكس انقلاباً أوسع في النظرة الأميركية إلى العالم: من تبني المشاريع القيمية إلى التماهي مع منطق القوة والوقائع.
لو سئل عشرة محللين سياسيين قبل عشرة أيام إن كانوا يرون أن لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ممكن، لأجاب تسعة منهم على الأقل بأن ذلك مستحيل أو بعيد المنال.
ومع ذلك، في الثالث عشر من أيار/ مايو، فاجأ ترامب المحللين ومعهم العالم بلقائه مع الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصياً، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتراضياً. وتلا اللقاء إعلانه قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وكان سبق ذلك اللقاء، وربما مهد له، لقاء جمع الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
جاء هذا التطور في لحظة حرجة من تاريخ سوريا والمنطقة، بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات والانقسامات والصراعات الإقليمية والدولية على الساحة السورية. لم يكن اللقاء مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل تجلياً لتحوّل استراتيجي كبير في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري، قد تكون له تداعيات بعيدة المدى. وهو بالتأكيد لم يأت من فراغ، بل كان – على الأرجح – نتيجة أسابيع من الحراك الدبلوماسي المكثف، أعادت خلاله قوى إقليمية أساسية، في مقدمها الرياض وأنقرة، وضع الملف السوري على طاولة البحث كأولوية سياسية مشتركة. في هذا السياق، يمكن القول إن قرار رفع العقوبات لم يكن أميركيا صرفاً، بل ثمرة توافق إقليمي – دولي على إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي ضمن معادلات جديدة تراعي المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
لا بد أن للرئيس ترامب حساباته الخاصة، فهو آخر من يهتم فعلاً لحال السوريين، وقد لعب – كعادته – لعبة ماكرة جعلت منه حديث العالم مجدداً. أما بالنسبة الى السوريين، فقد كان رفع العقوبات مطلباً محقاً، ولذلك انفجر الشارع السوري بفرحة عارمة فور سماعهم بالخبر، فهم يدركون أن من دون رفع العقوبات لن تكون هناك مساعدات ولا كهرباء ولا إعمار ولا وظائف.
أما الأميركيون، فهم منقسمون بين ثلاث فئات: فأنصار ترامب يسيرون معه بعيون مغمضة، لا يناقشون أياً من أفعاله؛ في حين ينقسم الآخرون بين من يتعامل مع رفع العقوبات بتسامح، آملا بأن يخفف ذلك من معاناة السوريين، وبين من يرى أن ترامب قد صافح فعلياً “إرهابياً” على يديه آثار دماء جنود أميركيين سقطوا في العراق.
ولسنا نعرف، على وجه اليقين، ما إذا كان الشرع قد قتل فعلاً جنوداً أميركيين، ولكننا نعلم أنه قاتل في صفوف “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” بقيادة أبي بكر البغدادي، الذي أصبح لاحقاً “خليفة” الدولة الإسلامية. وبينما يحتاج الجزم بمشاركته في تلك العمليات إلى تحقيقات مطوّلة وأحكام قضائية، فإن افتراض ذلك لا يبدو مبالغاً فيه.
في مقال افتتاحي نشرته “وول ستريت جورنال” غداة لقاء الرجلين في الرياض، لم تُخفِ الصحيفة – على رغم إقرارها بضرورة الواقعية السياسية – قلقها من انقلاب الخطاب الترامبي وتخلي واشنطن عن مشاريع “بناء الدولة” والديمقراطية الليبرالية. كما حذرت أصوات داخل الكونغرس والإعلام من أن “الرهان على جهادي سابق” قد تكون له نتائج عكسية، ما لم يقترن بتغيير جوهري في سلوك السلطة الجديدة.
ونحن نعلم أن الشرع قد واجه تهديداً بالاعتقال في حال حضوره القمة العربية المرتقبة في بغداد، على رغم دعوة رسمية تلقاها من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو ما اضطره للاعتذار عن عدم المشاركة.
تحوّل نوعي في المقاربة الأميركية
ما حصل لم يكن مجرد تعديل عابر في مقاربة واشنطن للملف السوري، بل تحولا جذريا في العقيدة التي حكمت سياساتها في الشرق الأوسط منذ عام 2011. فبعد سنوات من تبني نهج العزلة والعقوبات القصوى، جاءت مقاربة ترامب لتقلب المعادلة، مستبدلة خطاب بناء الدولة ونشر الديمقراطية بسياسة واقعية لا تقيس المواقف بالقيم بل بالنتائج.
ولم تكمن المفاجأة في رفع العقوبات فحسب، بل في هوية الطرف الذي استُقبل بهذا الانفتاح: رجل سبق أن صنّفته الولايات المتحدة كقيادي في جماعة جهادية، ورصدت مكافأة بملايين الدولارات للقبض عليه، ولا تزال حركته مدرجة على قوائم الإرهاب. واليوم، تصفه الإدارة الأميركية بأنه قائد قوي يملك فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى سوريا. هذا التحول الحاد في الخطاب والتوصيف يكاد يعلن نهاية فعلية لمرحلة “الحرب على الإرهاب” كنموذج ناظم للسياسة الأميركية، وبداية زمن جديد تُقدّم فيه البراغماتية على ما سواها.
شكّل لقاء ترامب والشرع لحظة مفصلية لا تخص سوريا وحدها، بل تعكس انقلاباً أوسع في النظرة الأميركية إلى العالم: من تبني المشاريع القيمية إلى التماهي مع منطق القوة والوقائع.
لم تعد واشنطن تسعى إلى تشكيل أنظمة على صورتها، بل باتت تقبل التفاهم مع أي سلطة قائمة، ما دامت قادرة على ضبط الأرض وتحقيق التوازنات التي تخدم مصالحها. لقد غادرت دورها كمشرّع ومعيار، لتغدو شريكاً في إدارة الأمر الواقع، أياً كانت هويته.
ولا ينبغي أن يُفهم لقاء الرياض على أنه نتاج مبادرة أميركية منفردة، بل هو ثمرة ترتيب دبلوماسي واسع شاركت فيه أطراف إقليمية ودولية وازنة، في مقدمها السعودية وتركيا وفرنسا. فقرار رفع العقوبات عن سوريا لم يصدر من فراغ، بل جاء تتويجاً لأسابيع من الحراك المنسّق، هدفه إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي ضمن معادلة جديدة تراعي مصالح الشركاء وتضمن استقرار المنطقة. بهذا المعنى، لم يكن ما حصل في الرياض مجرد لقاء ثنائي، بل محطة فاصلة في صفقة دبلوماسية جماعية أعادت رسم شروط الانخراط الدولي في الملف السوري، وفتحت الباب أمام إعادة تأهيل النظام الجديد وفق ضوابط إقليمية دقيقة.
ارتباك حكومي وتضخيم شعبي
على رغم أهمية الحدث، بدا في الأيام الأولى أن الحكومة السورية الانتقالية غائبة عن إدارة الخطاب السياسي والإعلامي المصاحب لقرار رفع العقوبات، فلم تُصدر أي بيانات فورية توضّح طبيعة القرار أو ترسم ملامح خريطة طريق لكيفية الاستفادة منه. وبدلاً من ذلك، تُرك المجال مفتوحاً لخطاب شعبي احتفالي، بلغ في بعض جوانبه حدّ الشماتة والاستعراض، ليملأ الفراغ ويعيد إلى الأذهان أنماطاً سلطوية سابقة كرّست منطق الغلبة على حساب منطق الشراكة.
وعلى رغم ظهور الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من إعلان قرار رفع العقوبات وإلقائه خطاباً مطولاً وجّه فيه رسائل شكر وتقدير لشعوب وقادة دول عربية وغربية دعمت سوريا الجديدة، بدا الخطاب أقرب إلى مهرجان شعاراتي منه إلى بيان سياسي رصين يُفترض به أن يحدّد ملامح المرحلة المقبلة. فقد غلبت عليه العبارات العاطفية والإنشائية، وتكرّرت فيه صيغ المديح والمبالغات، من دون أن يتضمن تصوراً واضحاً لخطة العمل المقبلة أو برنامجاً عملياً لمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والمؤسساتية الجسيمة التي تواجه البلاد. اكتفى الشرع بعرض علاقاته مع قادة دول الجوار، والاحتفاء برفع العقوبات، من دون أن يتطرّق إلى سبل ترجمة هذا التحوّل إلى سياسات ملموسة داخلية، أو إلى تقديم رؤية متماسكة لبناء دولة جامعة تتجاوز منطق الفصائل، وتؤسس لعقد اجتماعي جديد.
وبذلك، لم يساهم الخطاب في تبديد القلق الداخلي والدولي، بل ربما عمّق الشعور بأن السلطة الجديدة ما زالت تفتقر إلى خطاب دولة، وتكتفي بخطاب وجداني إنشائي لا يقدّم إجابات عن الأسئلة الكبرى.
كان الشرع، في خطابه ذاك، أقرب ما يكون إلى صورة الرئيس الهارب، وأشبه ما يكون بزعيم حزبي قديم، يستخدم اللغة نفسها والشعارات نفسها. فقد خاطب “الشعب السوري العظيم”، واستعاد صور المرحلة “المأساوية تحت حكم النظام الساقط”، حيث “قُتل الشعب، وهُجر الناس، وغُيّب الآلاف في سجون الظلام، وهُدمت مقدّرات الدولة، ونهبت بأيدي القتلة والسراق، وتحوّلت سوريا إلى بلد طارد لأبنائها وجيرانها”. ثم تحسّر على “سوريا الحضارة” التي باتت “غريبة عن تاريخها، وبعيدة عن أصالتها”، بينما “هناك في إدلب العز… كان يُبنى مستقبل سوريا الجديدة”، وقد “تحررت البلاد، وفرح العباد، وفرح معهم أشقاؤنا، بل والعالم بأسره، وعادت روح الانتماء لشعبنا، وظهر جلياً حرصه على دولته الجديدة”.
ومثل خطابات سابقة، غابت عن حديثه مفاهيم المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، في مقابل تكرار لافت وذي مغزى لكلمات من قبيل “الجوار” و”الجوار،” وكأنه يُسدّد ديناً أو يُوفي نذراً سياسياً. أما المديح، فقد توزّع على قادة المنطقة والرئيس الفرنسي ماكرون، واختُتم بالإشادة الخاصة بترامب، الذي “استجاب مشكوراً لهذا الحب، فكان قراره التاريخي الشجاع برفع العقوبات، باعثاً على نهضة الشعب، وأساساً لاستقرار المنطقة”.
صحيح أن رفع العقوبات عن سوريا مناسبة تستدعي الفرح، لكن الشجاعة السياسية كانت تقتضي من رئيس البلاد في خطابه أن يدعو إلى الوحدة لا أن يتعامل معها كأمر مفروغ منه، وأن يتعهد بفعل ما يلزم لتحقيقها، بما في ذلك محاسبة الجهات التي تفرّط بها وتهدّد مستقبل البلاد ككيان موحد ومستقل. فقد بدا الخطاب الذي تحدث فيه الشرع بعد رفع العقوبات، أقرب إلى نموذج بشار الأسد أو صفوان قدسي، لا إلى خطاب رجل يُفترض به أن يقود بلداً نحو تحوّل تاريخي. وبدلاً من تقديم صورة عن دولة تتجه نحو التعددية والمساءلة، صُوِّر القرار وكأنه “نصر” سياسي لطرف على حساب باقي الأطراف. هذا التوظيف الشعبوي للقرار يهدّد بتقويض الفرصة المتاحة، ويثير قلق الداخل والخارج من نوايا السلطة الجديدة.
ماذا عن الداخل؟
بينما تنشغل الحكومة السورية الجديدة في تلميع صورتها خارجياً، تبدو عاجزة عن تحسين شروط حياة السوريين وضمان أمنهم وسلامتهم. لا تزال البطالة في مستوياتها القصوى، وتنتشر حالات الانتقام الشخصي في مناطق عدة، من الساحل إلى حمص وحلب وريف حماة، فيما يزداد الوضع الأمني سوءاً في الساحل، حيث يفقد كثر من السكان العلويين الشعور بالأمان والكرامة. يتحدث هؤلاء عن سعار طائفي بات يهدد سلامتهم وهيبتهم، وعن تغييرات ديمغرافية متعمّدة يتم فيها احتلال منازلهم، المملوكة سابقاً لموالين للنظام المنهار، ومنحها لأشخاص وافدين من خارج المنطقة.
لا تزال البلاد عمليّاً مقسّمة، ولا تتجاوز سيطرة الحكومة شريطاً ضيقاً يمتد من حلب شمالاً إلى دمشق جنوباً، مروراً بالساحل. أما شرق البلاد وشماله الشرقي، فتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، بينما تفرض الفصائل المدعومة تركيا نفوذها على أجزاء واسعة من الشمال. ولا تتمتع الحكومة بأي سلطة حقيقية في السويداء ودرعا ومناطق من ريف دمشق، في حين تلوح في الأفق إشارات مقلقة عن تنامي حضور داعش في البادية.
ولا نرى للدولة دوراً في أي من هذه الملفات، كما لا نرى لها موقفاً واضحاً أو تدخلاً حاسماً في مواجهة مظاهر التشدّد الديني التي باتت تطغى على الفضاء العام: من الشوارع إلى الجامعات، ومن المؤسسات العامة إلى الفعاليات المجتمعية. فعلى رغم تطمينات الحكومة بعدم نيتها فرض تعليمات دينية تحدّ من الحريات، إلا أن انتشار هذه الظواهر – خصوصا في مناطق ذات تنوّع ديني – ولّد قلقاً واسعاً، يتضاعف مع غياب موقف رسمي يضبط العلاقة بين حرية الدعوة الدينية ومبدأ حيادية الدولة. وتزداد المخاوف مع تكرار هذه الممارسات في سياقات زمنية ومكانية غير مناسبة، وسط هشاشة مؤسسات الدولة وعجزها المتكرر عن ردعها.
حكاية ميرا
غير أن الغياب الأوضح والأكثر رمزية للدولة يتجلّى في قصة ميرا جلال ثابت. فتاة علوية من ريف حمص، اختفت بعد تلقيها اتصالاً للحضور إلى معهد إعداد المدرسين لأداء امتحان. وبعد أيام، ظهرت على شاشة قناة الإخبارية السورية، محجبة بالكامل بنقاب أزرق، تهمس بأنها تزوجت “عن حب”. غير أن ملامحها المنطفئة، والرجل الممسك بمعصمها، والزي الغريب عن بيئتها الاجتماعية، كلها عناصر فجّرت شكوكاً واسعة بشأن صحة الرواية الرسمية.
ما تمّ تسويقه بوصفه “عودة عروس” بدا لكثيرين “مسرحية رخيصة” لإخفاء جريمة اختطاف وتزويج قسري برعاية أمنية. فقد أنكرت السلطات مسؤوليتها، في حين تعرضت عائلة ميرا للتهديد، واعتُقل والدها. وعلى رغم ذلك، قُدِّمت رواية “الزواج الشرعي” كغطاء لتبرئة الدولة من أي شبهة تواطؤ، في مجتمع مرهق لا يرغب، أو لا يملك رفاهية الاعتراف، بأن أنماط العنف القديمة ما زالت تتكرر بأقنعة جديدة. تحولت ميرا إلى مرآة تعكس انهيار المعنى، وألم الحقيقة التي يخشى الجميع مواجهتها.
قصة ميرا تتجاوز بعدها الشخصي لتغدو رمزاً دالاً على مأزق الدولة السورية الجديدة، وتناقضات وعيها الجمعي. فلم تُفسَّر عودتها تفسيراً عقلانياً: هل اختُطفت؟ هل هربت؟ هل سُبيت؟ أم أنها اختارت مصيرها بفعل الحب؟ الكارثة لا تكمن في الإجابة، بل في طبيعة الأسئلة نفسها: أين الدولة؟ ولماذا غابت؟ ولماذا فشلت في الحضور حتى بعد وقوع الحدث؟ ومعها غاب أيضاً المجتمع كسلطة تضامنية، وفضل كثيرون تصديق الرواية الرسمية خشية انهيار الوهم القائم على أن الثورة نجحت، وأن الدولة الجديدة تختلف عمّا سبقها.
وأحسب أن من أولى أولويات الدولة، إن أرادت بناء شرعية حقيقية، أن تحضر داخلياً قبل أن تسعى الى الاعتراف الخارجي، وأن تكسب ثقة مجتمعها من خلال الأفعال لا الأقوال، وأن تنهض على أسس وطنية لا على شعارات طائفية أو انتصارات زائفة.
الحذر الغربي: دعم مشروط وتقييم مستمر
وعوداً إلى البداية، لم يُقابل قرار رفع العقوبات بحماسة غير مشروطة في الغرب. ففي الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما في الإعلام المحافظ، صدرت مقالات عدّة تشكّك في نوايا الرئيس الشرع، واعتبرت الخطوة “مجازفة عالية”. وفي افتتاحيتها المعنونة “ترامب يراهن على الجهادي السابق في سوريا”، رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التحوّل الأميركي يعبّر عن فكّ ارتباط متسارع بالقيم التي حكمت السياسة الخارجية لواشنطن طويلاً، ويكشف انزياحاً واضحاً نحو براغماتية صرفة تقيس السياسات بالمصالح لا بالمبادئ.
لكن هذه التحفظات، وعلى رغم كثافتها، لم تتحول إلى معارضة سياسية فعالة، ما يعني أن الغرب – وإنْ كان متردداً – قد قبل بالأمر الواقع، على أن يبقى أي انفتاح لاحق مشروطاً بالأداء الفعلي للحكومة السورية، لا بنواياها المعلنة أو خطاباتها الاحتفالية.
السؤال اليوم لم يعد فقط: ماذا يعني رفع العقوبات؟ بل: كيف سيتم توظيف هذا القرار؟ وهل تملك السلطة الجديدة القدرة والإرادة لترجمته إلى مكاسب وطنية شاملة، أم أنها ستُهدر فرصة نادرة كما أُهدرت سابقاتها؟ فهذه الخطوة الأميركية ليست نهاية مسار، بل بدايته. وقد تفضي إلى استقرار فعلي إذا أحسن التعاطي معها، أو إلى انتكاسة جديدة إذا بقيت البلاد أسيرة منطق الغلبة والاحتكار.
في كل الأحوال، تبقى المسؤولية داخلية قبل أن تكون خارجية. فإمّا أن تمضي الحكومة في تشكيل سلطة انتقالية جامعة تُعيد الاعتبار الى المؤسسات الوطنية، وتضع حداً لحكم الفصائل وتغوّل الأجهزة، وإمّا أن تعيد تدوير الأزمة في لبوس جديد أكثر هشاشة وخطورة.
وحده الأداء السياسي – لا الاحتفال الإعلامي – هو ما سيحسم المسار المقبل. وربما كانت الرسالة الأبلغ صدرت من الرئيس ترامب نفسه، حين قال: “دعونا نرى شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم”. فهل نراه حقا؟
درج
———————————–
ترامب والشرع.. ماذا تريد أميركا من سوريا؟/ صبا عبد اللطيف
18/5/2025
عادة ما تواجه الدول التي تخوض فترات ما بعد النزاعات المسلحة، وتعاني من عدم استقرار أمني واضطراب سياسي، تحديات كبيرة موروثة من زمان الصراع، وهو ما يتطلب عادة من تلك الدول، والأنظمة الجديدة التي تحكمها، البحث عن توازن خاص ودقيق في علاقاتها الدولية لضمان الدعم اللازم للدولة الجديدة، مع الحد من التنازلات التي قد تُفرض عليها.
وفي السياق السوري، تتعامل الإدارة الجديدة مع الإرث الثقيل لنظام الأسد، وهي تتلمس خطاها للبحث عن التوازن المطلوب وسط العديد من الصراعات المحتدمة والقوى الإقليمية والدولية الساعية لضمان مصالحها.
وتُعدّ الولايات المتحدة الطرف الأهم في صياغة هذا التوازن، نظرًا لاستمرار وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، ودورها في دعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتحكّمها المباشر في العديد من أدوات الضغط الاقتصادي والعسكري. غير أن قمة الرياض التي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار 2025، مثّلت نقطة تحوّل في السياسة الأميركية تجاه دمشق، التي تزامنت مع الإعلان عن بدء رفع العقوبات، مقابل التزامات سياسية وأمنية محددة.
كما ظهرت مؤشرات على تحول أميركي في ملف “قسد”، مع إبداء ترامب رغبته بأن تتولى الحكومة السورية الجديدة مسؤولية الإشراف على مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (الواقعة حاليا تحت سيطرة قسد)، بحسب ما ورد في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت على منصة إكس. وتعبر هذه الخطوة عن استعداد الولايات المتحدة لتقليص تحالفها مع قسد، والتعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
بالتوازي، تلعب واشنطن مؤخرا -على ما يبدو- دورًا موازنًا في ضبط التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، ورغم امتناعها عن انتقاد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع قرب العاصمة دمشق تحت ذريعة حماية الدروز، فإنها وجهت الدعوة إلى “خفض التصعيد” و”حماية الأقليات الدينية”.
يركز هذا المقال على تحليل الدور الأمني الأميركي في سوريا ما بعد الأسد، وعلى المواقف المتبادلة التي قد تشكل مستقبل العلاقة الثنائية، من خلال تفكيك ثلاث قضايا محورية: سياسة العقوبات والربط بين رفعها وبين شروط أمنية سياسية محددة يتعين على النظام السوري الجديد الوفاء بها، ودور واشنطن في إدارة التوتر الإسرائيلي السوري، وأخيرا مسار العلاقة بين الحكومة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية.
العقوبات.. بوابة الانفتاح على سوريا
مثّل اللقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب مؤخرا تطورًا نوعيًا غير مسبوق في مسار العلاقات السورية الأميركية. فهذا الاجتماع، الذي عُقد في الرياض برعاية سعودية، هو الأول من نوعه بين رئيس أميركي ورئيس سوري منذ 25 عامًا، إذ تعود آخر قمة مماثلة إلى لقاء حافظ الأسد وبيل كلينتون عام 2000.
وحضر القمة إلى جانب ترامب والشرع، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (مضيف اللقاء) بينما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر دائرة الاتصال المرئي، مما أبرز طبيعة التنسيق الدولي والإقليمي خلف هذا الحدث المفصلي.
ويعكس هذا اللقاء مدى الأهمية التي توليها واشنطن للمتغيرات الجديدة في سوريا، كما يعكس استعداد ترامب للتصرف بشكل غير تقليدي أحيانا، حيث كان اللقاء مع الشرع محل خلاف داخل فريق الرئيس الأميركي حتى قبيل ساعات قليلة من زيارته للمنطقة.
بيد أن لقاء ترامب والشرع لم يكن التطور الوحيد من ترامب تجاه سوريا، حيث أعلن الرئيس الأميركي عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بصورة تدريجية. ووصف ترامب تلك العقوبات بأنها “وحشية” و”معيقة”، مؤكدًا أنه حان الوقت لكي “تنهض سوريا” من جديد. جاء هذا الإعلان بعد أكثر من عقد من عقوبات مشدّدة عزلت سوريا عن المنظومة المالية العالمية بشكل كلي.
ومن الواضح أن واشنطن اعتمدت مقاربة جديدة في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، تنتقل فيها من سياسة العزل والعقاب إلى سياسة الانخراط المشروط والدعم الحذر، فقد أبدى المسؤولون الأميركيون استعدادهم للعمل مع سلطات دمشق الانتقالية إذا التزمت بمسار التسوية السياسية وراعت المطالب الدولية، وهو نهج مقارب لرؤية حلفاء أميركا الأوروبيين الذين اعتبروا تشكيل الحكومة الجديدة معلمًا مهمًا في الانتقال السياسي في سوريا.
لم يكن التحول في الموقف الأميركي حيال العقوبات وليد قرار أحادي، بل جاء ثمرة وساطات إقليمية مكثفة وجهود دبلوماسية مشتركة، فقد لعبت السعودية وتركيا وقطر دورًا محوريًا في إقناع إدارة ترامب بمنح دمشق فرصة جديدة؛ إذ كشف ترامب نفسه أن ولي العهد السعودي والرئيس التركي أسهما في التوسط لترتيب اجتماعه مع الرئيس الشرع ولاتخاذ قرار رفع العقوبات.
كما رحبت قطر علنًا بالتوجه الأميركي الجديد، وبرز دعمها عبر القنوات الدبلوماسية لهذه الخطوة. ومن جانبها وجّهت الحكومة السورية الشكر إلى السعودية وقطر وتركيا لمساندتها جهود إنهاء العزلة الاقتصادية عن دمشق، معتبرةً أن وقوف الأشقاء العرب إلى جانبها ساهم بشكل مباشر في صدور القرار الأميركي.
ويعكس هذا التنسيق توجّها إقليميًا على ضرورة انتشال الاقتصاد السوري من أزمته الخانقة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من ترسيخ الاستقرار في سوريا الجديدة.
خلال المحادثات، طرح الرئيس ترامب بصورة واضحة خارطة مطالب أميركية من القيادة السورية الجديدة كأثمان سياسية وأمنية للتطبيع الكامل معها ورفع العقوبات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. ووفق ما ورد في بيان متحدثة البيت الأبيض، حدد ترامب خمسة مطالب أساسية موجّهة للرئيس الشرع.
أول هذه المطالب هو انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في تحول جذري عن نهج الصراع السابق، وثانيها هو إخراج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا، ويُفهَم منه خصوصًا المليشيات غير السورية التي كانت تنشط إبان الحرب (وفي طليعتها القوات الموالية لإيران)، كما يشمل أيضا المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الثورة السورية وجرى دمج بعضهم مؤخرا ضمن وزارة الدفاع السورية الجديدة.
أما المطلب الثالث فيتعلق بترحيل كوادر الفصائل الفلسطينية المسلحة المتواجدة على الأراضي السورية (وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي) إلى خارج البلاد، بما يبدد هواجس إسرائيل والولايات المتحدة حيال وجود تلك الجماعات.
بعد ذلك يأتي المطلب الرابع وهو تعزيز التعاون مع واشنطن في مكافحة تنظيم الدولة ومنع عودته للظهور، بينما يُلزِم المطلب الخامس والأخير دمشق بتحمّل المسؤولية الكاملة عن مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة في شمال شرق البلاد بدلًا من الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.
من جانبه، أبدى الرئيس أحمد الشرع مرونة لافتة إزاء تلك المطالب، سعيًا منه للاستفادة القصوى من فرصة الانفتاح الأميركي. وبحسب بيان متحدثة البيت الأبيض، شكر الشرع الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان والرئيس أردوغان على جهودهم في تنظيم اللقاء، معتبرًا أن خروج القوات الإيرانية من سوريا قد أتاح “فرصة مهمة” لاستعادة سيادة سوريا الكاملة وبناء شراكات جديدة.
كما أكّد الشرع -وفق البيان- التزامه الثابت باتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974 كأساس لضمان أمن الحدود، وأبدى انفتاحًا على فكرة التحاق سوريا بركب “السلام الإقليمي” عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي خطوة رمزية تعبّر عن الرغبة في كسب ثقة الأميركيين، عرض منح الشركات الأميركية أولوية في الاستثمار بقطاع النفط والغاز السوري. هذه المواقف السورية الإيجابية قوبلت بترحيب حذر من الجانب الأميركي، حيث اعتبر ترامب أن لدى الشرع فرصة تاريخية لتحقيق تحوّل حقيقي في بلاده إذا نفّذ تلك التعهدات، مؤكدًا استعداد واشنطن لمواكبة هذا التحول ودعمه بخطوات ملموسة على الأرض.
واشنطن بين دمشق وإسرائيل
يُعد ملف العلاقة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الأراضي السورية من أعقد التحديات التي تواجه السياسة الأميركية تجاه دمشق ما بعد الأسد، إذ لطالما شكلت الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، خصوصًا ضد أهداف مرتبطة بإيران أو حزب الله اللبناني، عامل توتر دائم.
ومع سقوط نظام الأسد، وظهور حكومة انتقالية بدأت تنال دعما وزخما دوليا، دخلت واشنطن في حالة توازن دبلوماسي حساس بين شراكتها التاريخية مع إسرائيل وبين محاولتها دعم الاستقرار السياسي في سوريا الجديدة.
من جهة، لا تخفي تل أبيب نيتها في مواصلة نهجها العسكري، وتستغل انشغال السوريين بالانتقال السياسي من أجل ترسيخ وجودها في الأراضي والأجواء السورية، بل وتُبرر تصعيدها أحيانًا بذريعة “حماية الأقليات” كما حصل عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الجمهوري.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تؤيد هذه العملية بشكل علني، فإنها امتنعت عن إدانتها أيضًا. وبدلاً من ذلك، ركّز بيان الخارجية الأميركية على إدانة ما وصفه “بالعنف والتحريض ضد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا”، داعيا إلى “خفض التصعيد وحماية المكونات الدينية، في موقف فسّره مراقبون على أنه تماهٍ ضمني مع الرواية الإسرائيلية دون تبنٍّ مباشر للضربة.
وقد رأت واشنطن أن تحميل دمشق مسؤولية التوتر الطائفي في مناطق مثل جرمانا والسويداء، يمكّنها من توجيه رسالة مزدوجة: فهي من جهة تُبقي على دعمها لإسرائيل، ومن جهة أخرى تضغط على الحكومة السورية الجديدة “لضبط سلوكها الأمني”، دون تقويض مسارها الانتقالي. غير أن واشنطن، وعلى النقيض من إسرائيل، تظل حذرة من أي تصعيد يمكن أن يقوض الانتقال السياسي في سوريا.
يأتي هذا الحذر الأميركي في ظل قناعة متزايدة لدى الأوساط الغربية بأن إسرائيل تسعى، عبر تكثيف عملياتها العسكرية، إلى فرض وقائع جديدة على دمشق، مستغلة حالة السيولة السياسية وضعف البنية العسكرية للدولة بعد الحرب، وأن الاستراتيجية الإسرائيلية الراهنة تقوم على الضغط العسكري-الدبلوماسي لإجبار الحكومة السورية الجديدة على قبول الوجود الإسرائيلي على أراضيها وفي أجوائها كأمر واقع، ووضع ضغوط مستمرة على الإدارة الجديدة في دمشق.
من هذا المنطلق، تبدو واشنطن وكأنها تلعب دور “الكابح” في هذا المسار، فهي راضية عن النفوذ الإسرائيلي في معادلة الردع الإقليمي بما يشمل سوريا، لكنها لا ترغب أيضا في زيادة التصعيد العسكري إلى الحد الذي يخلق فوضى تقوض عملية الانتقال السياسي في دمشق. وفي ضوء هذه الرغبة الأميركية، يمكننا قراءة التهدئة النسبية في نبرة المسؤولين الإسرائيليين تجاه النظام السوري الجديد.
ففي 12 مايو/أيار الحالي، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، بأن إسرائيل “تسعى لعلاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة”، رغم إقراره بوجود مخاوف أمنية مستمرة تجاهها. التحول في لهجة إسرائيل لم يأتِ من فراغ، بل تزامن مع إعلان استعادة رفات الجندي تسفيكا فيلدمان الذي فُقد منذ عام 1982، في عملية نُفّذت داخل العمق السوري، ما اعتُبر مؤشرا على وجود تفاهمات أمنية غير معلنة بين الطرفين.
بالتوازي مع هذه التطورات، خرج الرئيس السوري أحمد الشرع عن المألوف، معلنًا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، تهدف إلى تهدئة التوترات في الجنوب السوري، ومنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة. كما أكد التزام حكومته باتفاقية فصل القوات لعام 1974، في خطوة فُهمت على أنها رغبة سورية في احتواء التصعيد بدل مواجهته، وهو ما ينسجم مع تطلعات الولايات المتحدة لاستقرار سياسي وأمني طويل الأمد في سوريا.
ومن جهة واشنطن، جاءت أبرز إشارة سياسية في هذا السياق من رفض إدارة ترامب طلبا إسرائيليا بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية ضد دمشق، وهو ما كشفته تقارير صحفية مؤخرا.
هذا الرفض عكس إدراكًا أميركيًا بأن المبالغة في الضغط على سوريا الجديدة قد تعيق انخراطها البنّاء في الملفات الإقليمية، بما في ذلك ملف التطبيع مع إسرائيل نفسه. كما يبرز أن واشنطن صارت تنظر بعين القلق إلى أي سلوك إسرائيلي قد يقوض مشروعها الناشئ في بناء شريك سوري موثوق ومتوازن.
في المحصلة، تلعب الولايات المتحدة في هذه المرحلة دورًا معقّدًا ومزدوجًا بين دعمها لإسرائيل ورغبتها في الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة وتجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية تعيق عملية الانتقال السياسي السورية.
ويبدو أن هذا التوازن سيتطلب من واشنطن مناورة دقيقة مستمرة بين الحليف التقليدي والشريك المحتمل الجديد، لضمان استقرار المعادلة الأمنية في مرحلة ما بعد الأسد.
سوريا – دمشق – وصف اتفاق دمشق و”قسد” بأنه اتفاق تاريخي ويمهد لمرحلة جديدة في سوريا (الجزيرة)
قسد ودمشق.. دمج معقّد في ظل التحول الأميركي
يُعد الدعم الأميركي المستمر لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أحد أبرز مصادر التوتر المحتمل بين واشنطن والحكومة السورية الجديدة. فمنذ وقت مبكر من عمر الصراع في سوريا، اعتمدت الولايات المتحدة على “قسد” شريكًا أساسيًا في الحرب ضد تنظيم الدولة، ووفرت لها غطاءً جويًا ودعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا.
ورغم زوال نظام الأسد، لا تزال واشنطن تحتفظ بحوالي 900 جندي أميركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وهو ما يُثير مخاوف القيادة السورية الجديدة من خطر التفكك الوطني أو محاولات الأكراد لفرض حكم ذاتي خارج سيطرة الدولة المركزية.
وقد شهد شهر مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق غير مسبوق بين قيادة قوات قسد والحكومة السورية الانتقالية في دمشق. وقتها، ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي وهما يوقعان وثيقة من 8 بنود تمهد لإعادة توحيد الأراضي السورية تحت سلطة الدولة.
نص الاتفاق على دمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة، ووضع الموارد الاستراتيجية (المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز) تحت سيطرة الحكومة المركزية، واعتبر الاتفاق خطوة مهمة لإنهاء الانقسام الجغرافي الذي عانته سوريا، وخطوة على طريق الاستقرار السياسي والأمني.
وقد رحبت واشنطن وحلفاؤها الغربيون بالاتفاق، إذ أعلنت الخارجية الأميركية دعمها لاتفاق الشرع-عبدي بوصفه “خطوة نحو سوريا جديدة جامعة لكل أبنائها”، كما كشف مسؤولون أميركيون أن واشنطن أدّت دور الوسيط خلف الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الأكراد والحكومة السورية، وفق ما أوردته “وول ستريت جورنال”.
غير أن تنفيذ هذا الاتفاق، رغم الترحيب الإقليمي والدولي به، لم يكن سَلِسًا كما بدا في بادئ الأمر. فمن جهة، أعلنت دمشق استلامها السيطرة على بعض الحقول الحيوية مثل العمر والشدادي، وبدأت عمليات تنسيق أمني مع قسد ضد فلول تنظيم الدولة، بدعم وتسهيل من واشنطن. ومن جهة أخرى، برزت عدة تحديات معقدة بدأت تُهدّد استمرارية التفاهم، وعلى رأسها الطريقة التي سيجري بها دمج الفصائل الكردية ضمن الجيش السوري الجديد.
ومع توقيع الاتفاق، أوفدت تركيا مسؤولين إلى دمشق لبحث تفاصيل الدمج، وأكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وفدًا تركيًا ناقش اتفاق الحكومة السورية وقسد خلال زيارة للعاصمة السورية، وفق ما أوردته وكالة رويترز. وتشمل اهتمامات تركيا الرئيسية بشأن الاتفاق؛ ضمان عدم وجود مقاتلين أجانب منتمين إلى حزب العمال الكردستاني (الذي أعلن حل نفسه مؤخرا) ضمن الهيكلية الجديدة، مع إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ضمان أمن الحدود وسلامة المجتمعات المحلية مثل التركمان.
في الداخل السوري، لم يكن المشهد أقل اضطرابا، إذ تسبّب الاتفاق في انقسام داخلي حاد ضمن صفوف قسد نفسها، حيث عبّر عدد من القادة العسكريين المحليين (خصوصًا في منبج والقامشلي) عن رفضهم المطلق للاندماج الكامل ضمن الجيش السوري، واعتبروا ذلك تهديدًا لوجودهم، حتى إن بعضهم طالب باستمرار الحكم الذاتي تحت إشراف دولي، بينما لوّح آخرون بتعليق التعاون مع دمشق إذا لم تُحترم الخصوصية الثقافية والإدارية للأكراد.
ولم يكن الغموض بشأن مستقبل الوجود الأميركي في المنطقة أقل تأثيرًا، فواشنطن رغم إشرافها على صياغة الاتفاق، لم تعلن عن أي جدول زمني واضح لانسحاب قواتها. هذا التأرجح أربك حسابات قسد، التي تخشى أن تُترك في مواجهة مباشرة مع الحكومة الجديدة أو مع تركيا حال حدوث انسحاب مفاجئ.
غير أن التحول الواضح في السياسة تجاه قسد، تمثّل في إدراج تفهم جوهري خلال قمة الرياض التي جمعت الرئيسين الأميركي والسوري، إذ اشترط ترامب على الحكومة السورية تقديم ضمانات واضحة بشأن إدارة مراكز اعتقال عناصر “تنظيم الدولة” شمال شرق البلاد، والتي تديرها قسد منذ سنوات.
هذا المطلب يعد مؤشرا أوليا لا يمكن تجاهله على تراجع أهمية قسد بالنسبة للأميركيين، ورغبة واشنطن في نقل الأعباء الأمنية إلى الدولة السورية الجديدة. ويشير ذلك -ربما- أن واشنطن ترى أن مسؤولية احتجاز ومحاكمة العناصر المتطرفة يجب أن تتحول من كيان غير معترف به دوليًا إلى حكومة شرعية مركزية قادرة على إنفاذ القانون في جميع أراضيها.
باختصار، يمكن القول إن اتفاق مارس/آذار 2025 بين قسد والحكومة السورية أسس لمرحلة جديدة من التفاعل السياسي – الأمني، لكنه ما زال هشًا ويواجه تحديات داخلية وإقليمية معقدة. ويظل نجاحه مرهونا بمعالجة الانقسامات الكردية الداخلية، واستيعاب المكوّن الكردي دون تهميش، والأهم؛ التزام قسد بتعهداتها بالتخلي عن الطموحات الانفصالية، فضلا عن الضمانات الأميركية لتنفيذ الاتفاق على الأقل في المرحلة الانتقالية، حيث ترى الحكومة السورية الجديدة أن إعادة بناء هياكل الدولة الأمنية لا يمكن أن تُجرى في ظل جيش موازٍ، وتطالب واشنطن بوقف دعم قسد أو ضمان دمجها في المؤسسة العسكرية الوطنية.
إدارة الانتقال
في الختام، يتضح أن الدور الأميركي في سوريا ما بعد الأسد لم يتراجع، بل أعيد تشكيله وفق مقاربة أكثر واقعية تتلاءم مع الحقائق الجديدة، حيث انتقلت واشنطن من سياسة إدارة الصراع إلى إدارة الانتقال، ومن دعم الكيانات غير الرسمية إلى التنسيق المشروط مع الدولة المركزية الناشئة. ويبرز ذلك بوضوح في ثلاثة ملفات مركزية شكّلت اختبارًا لجدية التحول الأميركي:
أولا، مثّلت العقوبات أداة مركزية في يد واشنطن استخدمتها للضغط على النظام السابق، لكنها تحوّلت في عهد الحكومة الانتقالية إلى ورقة مساومة، كما أظهرت قمة الرياض التي ربط فيها الرئيس ترامب رفع العقوبات بخارطة شروط أمنية وسياسية واضحة، في مقدمتها سياسة النظام الجديد تجاه إسرائيل ومصير “المليشيات الأجنبية”، وهي ملفات شائكة قابلة للانفجار في أي وقت.
ثانيًا، تعمل واشنطن على ضبط إيقاع التصعيد الإسرائيلي داخل سوريا. ورغم تمسّك الولايات المتحدة بحق إسرائيل “المزعوم” في “الدفاع عن النفس”، فإنها عبّرت عن رفض “ضمني” لتوسيع دائرة العمليات على نحو يهدد الاستقرار السياسي السوري، وهو ما يعكس رغبتها في احتواء الحليف، لا إطلاق يده دون حساب.
ثالثا، حافظت الولايات المتحدة على دعم قوات قسد لسنوات كشريك ميداني، لكنها أظهرت بوادر تحوّل استراتيجي من خلال الدفع نحو اتفاق الدمج مع دمشق، ثم اشتراطها في قمة الرياض أن تتحمل الحكومة السورية مسؤولية سجون مقاتلي تنظيم الدولة، في ما يُعدّ تخليًا تدريجيًا عن “قسد” كشريك سياسي، والبحث لصالح عملية انتقال سياسي ترغب واشنطن أن تكون أكثر سلاسة وتنظيما.
في المحصلة، ترسم هذه الوقائع ملامح دور أميركي جديد في سوريا لا هو بالانسحاب الكامل، ولا بالتورط المباشر، بل شراكة أمنية مشروطة، تتقاطع فيها مصالح واشنطن مع استقرار دمشق.
وهي معادلة دقيقة، يبدو أن نجاحها مرتبط بقدرة الطرف السوري على التوازن بين الاستجابة للمطالب الغربية دون التفريط في سيادة البلاد، كما يرتبط بقدرة واشنطن على ضبط سقف مطالبها من النظام الجديد دون أن تخاطر بتقويضه، مع منحه ما يكفي من الحوافز لاستكمال عملية الاندماج ضمن المجتمع الدولي.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية
——————————-
اللحظة التي غيّرت ترامب تجاه سوريا/ محمد سرميني
18/5/2025
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوساط الدولية بإعلانه رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية، وذلك في لحظة سياسية كانت كل المؤشرات تشير فيها إلى احتمال انحيازه لخيار اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدفع باتجاه تقسيم سوريا إلى دُويلات مذهبية وإثنية متناحرة.
هذا القرار، الذي جاء من قلب الرياض لا من واشنطن، مثّل انعطافة كبرى في مقاربة الملف السوري، وأطلق دينامية إقليمية جديدة تمحورت حول إعادة تأهيل سوريا كدولة موحدة ومستقرة، ضمن توازنات ترعاها قوى إقليمية وازنة.
لم يكن الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا مجرّد خطوةٍ مفاجئة أو تحوّلٍ تكتيكي عابر. بل هو، في جوهره، انعكاس لتحوّل أوسع في موازين القوى الإقليمية والدولية، ونتاج لتراكمات سياسية ودبلوماسية تقودها قوى إقليمية وازنة، وعلى رأسها السعودية وتركيا وقطر، ضمن رؤية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يتجاوز الحسابات الضيقة للسنوات الماضية.
الحضور السعودي: رافعة سياسية واقتصادية
يبرز الحضور السعودي، ممثلًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كعنصر حاسم في صياغة هذا التحول. فالسعودية لم تعد فاعلًا تقليديًا يكتفي بإدارة توازنات مالية أو دينية، بل أصبحت مركز ثقل إستراتيجي في المنطقة، وقائدة مسارات إعادة التموضع في العالم العربي.
المبادرات السعودية تجاه سوريا تنطلق من فهم واضح لمعادلة الأمن والاستقرار: لا يمكن أن تستقر المنطقة في ظل استمرار انهيار الدولة السورية، ولا يمكن للسعودية أن تقود مشروعًا تنمويًا متكاملًا في الخليج والشرق الأوسط دون تطويق بؤر التوتر الرئيسية.
رفع العقوبات، في هذا السياق، لا يخدم فقط مصالح دمشق، بل يفتح الباب أمام مشروع اقتصادي- سياسي طموح، يمكن للسعودية أن تكون راعيه الأساسي.
ومن خلال تحفيز الاستثمارات في البنى التحتية، والتعليم، والطاقة، يمكن تحويل سوريا من عبء إقليمي إلى فرصة للتكامل والتنمية، خصوصًا في ظل حاجة السوق السورية المدمّرة إلى كل أشكال الدعم والإعمار.
الدور التركي: مقاربة أمنية وتنموية مزدوجة
تلعب تركيا دورًا محوريًا، لكن من زاوية مختلفة. فأنقرة التي كانت لعقد من الزمن جزءًا من الأزمة، باتت اليوم أكثر انخراطًا في مسار الحل، لكنها تحرص على حماية مصالحها الأمنية في الشمال السوري، خصوصًا ما يتعلق بملف الأكراد وتنظيم “قسد”.
وبقدر ما تسعى تركيا إلى إعادة ضبط علاقتها بسوريا، فإنها تدرك أن رفع العقوبات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار سيفتحان المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط المناطق الحدودية بسوريا من جديد، وتقلص من تدفق اللاجئين، وتعيد الاستقرار إلى الجنوب التركي.
تركيا تنظر إلى الملف السوري من منظارين: الأول أمني بحت يهدف إلى منع إنشاء كيان كردي مستقل، والثاني اقتصادي يهدف إلى استثمار مرحلة إعادة الإعمار في سوريا لتوسيع نفوذ الشركات التركية، ودمج الاقتصاد السوري تدريجيًا في المحور التجاري بين أنقرة ودول الخليج.
قطر: دبلوماسية مرنة وشريك تنموي واعد
أما قطر، التي لطالما تموضعت في قلب الملفات الإقليمية الحساسة، فهي تستثمر في المرحلة الجديدة بسلاسة دبلوماسية واقتصادية. من خلال علاقاتها المتقدمة مع الولايات المتحدة من جهة، وقدرتها على فتح قنوات اتصال مع الأطراف السورية والدولية من جهة أخرى، تشكل الدوحة جسرًا مهمًا في مرحلة الوساطة السياسية، وتطرح نفسها كشريك اقتصادي قادر على ضخّ الاستثمارات، وتفعيل الحضور العربي في مرحلة ما بعد الحرب.
الدوحة، التي ساهمت في إعادة توجيه بوصلة الحلّ في عدد من الأزمات الإقليمية (أفغانستان نموذجًا)، ترى في سوريا فرصة جديدة لتعزيز الاستقرار، وترسيخ توازن إقليمي يصب في مصلحة الجميع، شرط أن تكون المعادلة قائمة على احترام السيادة السورية، والانفتاح على حلول سياسية عادلة.
تكتل ثلاثي بفرص استثنائية
إن اجتماع هذه القوى الثلاث: السعودية وتركيا وقطر، على خط تحوّل سياسي- اقتصادي في سوريا، يشكّل بذاته حدثًا إستراتيجيًا غير مسبوق. رغم الاختلافات السابقة، فإن هذا التكتل بات يرى في استقرار سوريا فرصة مشتركة، لا تهديدًا متبادلًا. وهو ما يعزز فرص الاستثمار في الملفات الآتية:
إعادة الإعمار: وهي عملية ستتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وستكون مجدية لدول الخليج وتركيا من حيث العقود والبنى التحتية والخدمات.
إعادة تموضع اللاجئين: حيث ستساهم بيئة مستقرة ومموّلة بإعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ما تريده أنقرة والرياض والدوحة.
التوازن مع إيران: عبر إخراج طهران من الساحة السورية تدريجيًا بالوسائل الاقتصادية والسياسية لا العسكرية.
التكامل الأمني: من خلال التنسيق الاستخباراتي حول التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمليشيات غير المنضبطة.
اقتصاد مفتوح: لا يمكن القفز فوق أهمية رفع العقوبات والتي ستحفز المستثمرين بالدخول بحجم أوسع في قطاعات الطاقة والبيئة والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وخاصة المستثمرين السوريين في دول الخليج وأوروبا.
من العقوبات إلى التحوّل: لحظة إستراتيجية
رفع العقوبات، إذًا، لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تحوّل في الرؤية الأميركية تجاه سوريا والمنطقة. إذ بات واضحًا أن الإدارة الأميركية لم تعد تؤمن بأن إضعاف سوريا يخدم المصالح الإستراتيجية، بل ترى أن سوريا مستقرة ومنفتحة على الخليج وتركيا وأوروبا ستكون شريكًا أفضل في محاربة الإرهاب وضبط الحدود وتثبيت الاستقرار الإقليمي.
يأتي هذا التحول بالتزامن مع رغبة الولايات المتحدة في إنهاء أزمات الشرق الأوسط، وتوجيه الموارد والتركيز نحو آسيا ومواجهة الصين. وبالتالي، فإن تسوية الملف السوري تندرج ضمن خطة “تصفير النزاعات” في المنطقة.
لحظة اختبار للقيادة السورية
لكن كل هذه الفرص، تبقى رهنًا بمدى استعداد القيادة السورية لالتقاط التحول والانخراط في مشروع إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
سوريا ما بعد العقوبات ليست كسابقتها، والمطلوب اليوم ليس فقط إعادة الإعمار بالحجارة، بل بناء عقد اجتماعي جديد، يضمن المشاركة السياسية، ويخرج السوريين من دوامة الخوف والانقسام، ويعيد دمجهم في محيطهم العربي.
إن الفرصة الإستراتيجية التي تتشكل اليوم بقيادة السعودية وشراكة قطر وتركيا، تحتاج إلى شجاعة سياسية من دمشق، واستعداد للانفتاح، وتجاوز مرحلة العزلة الدولية التي دامت لأكثر من عقد.
فإما أن تتحول سوريا إلى “خلية نحل” كما يقول بعض المحللين الخليجيين، وإما أن تبقى رهينة ماضٍ دموي يعيد إنتاج نفسه في كل دورة عنف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
المدير العام لمركز جسور للدراسات
الجزيرة
——————————-
ترامب في الخليج: تعزيز دور الحلفاء التقليديين… «هدية سورية» بديلا عن «خيبة غزة» والصفقة الكبرى لم يحن أوانها بعد/ رلى موفَّق
18 أيار 2025
شهد الخليج العربي أربعة أيام سياسية حافلة بين 13 و16 أيار/مايو الحالي. خصَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة بالزيارة الخارجية الأولى في ولايته الثانية كما فعل في ولايته الأولى، مع فارق 8 سنوات حصلت فيها أحداث وحروب وتحولات كبرى في المنطقة والعالم، لا تزال تداعياتها مستمرة، وفي مقدمها غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، وهجوم «7 أكتوبر» 2023 الذي شنَّته حركة «حماس» على إسرائيل، والذي اعتُبر بمنزلة «11 أيلول» إسرائيلي.
في هذه الفترة الزمنية، تمَّ توقيع اتفاق سعودي – إيراني برعاية صينية لإعادة العلاقات الدبلوماسية في 10 آذار/مارس 2023 شكَّل الدخول السياسي الأول لبكين إلى المنطقة. وكانت المملكة العربية السعودية تقدَّمت بخطوات ملموسة في المفاوضات مع الأمريكيين حول مسار التطبيع مع إسرائيل وفق الرؤية السعودية التي استندت إلى عوامل أساسية هي توقيع اتفاقية دفاعية سعودية – أمريكية، وإنشاء برنامج نووي سلمي مدني في المملكة برعاية أمريكية، والتوصل إلى اتفاق لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يلبّي احتياجات الفلسطينيين ويجلب الهدوء إلى المنطقة. حينها كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للمرة الأولى، عبر مقابلته مع «فوكس نيوز» في 21 أيلول/سبتمبر 2023 عن أن السعودية تقترب أكثر من التطبيع مع إسرائيل، وأن المفاوضات جادة. وكان سبق ذلك في الشهر نفسه الإعلان عن الممر الاقتصادي الهندي – الشرقي أوسطي الأوروبي خلال قمة العشرين في نيودلهي، والذي قُرئ في السياسة أنه مشروع في مواجهة مشروع «الطريق والحزام» الصيني.
نجحت دول الخليج في الخروج من دائرة الاصطفاف القاتل في الحرب الروسية على أوكرانيا، واستفادت من لعب دور «الحياد الإيجابي» وتوسيع مروحة الاتفاقات السياسية والشراكات الاقتصادية، ولا سيما أن لكل من دول الخليج رؤيتها الاقتصادية. وتعوِّل المملكة العربية السعودية على نجاح «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد في 25 نيسان/أبريل 2016، وهو الذي قال قبل سنوات: «أعتقد أن أوروبا الجديدة ستكون الشرق الأوسط».
ما الذي تحقَّق خلال زيارة ترامب للسعودية وقطر والإمارات على صعيد الصفقات الاستثمارية؟
أعلنت الرياض عن التزامها باستثمارات تُقدَّر بـ600 مليار دولار. وتَّم توقيع اتفاقية مبيعات دفاعية وصفها ترامب بأنها الأكبر في التاريخ بقيمة تقارب 142 مليار دولار تهدف إلى تزويد المملكة بمعدات وخدمات قتالية متطورة. المملكة تطمح للحصول على طائرات «إف 35»، تعزِّز فيها قدراتها العسكرية، وهي طائرات من الجيل الخامس يُعطي سلاح الجو الإسرائيلي تفوقاً عسكرياً على الآخرين في الشرق الأوسط. شهدت زيارة ترامب توقيع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار في مشاريع الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات. هذا فيما تمَّ في الدوحة توقيع اتفاق بقيمة 200 مليار دولار لشراء الخطوط الجوية القطرية طائرات بوينغ، فيما حظيت الإمارات بشراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يُحوِّلها إلى مركز عالمي للتكنولوجيا، في وقت أضحى فيه الذكاء الاصطناعي ساحة تنافس جيوسياسي. وسيضع هذا التحوُّل الخليج العربي عموماً، والإمارات خصوصاً، في موقع متقدِّم بين دول العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بما سيعيد رسم خارطة القوة التكنولوجية في العالم.
لا شك في أن الرئيس الأمريكي الحالي يعتريه هاجس الاستثمارات، وكلما كانت قياسية كان ذلك معياراً لنجاحه في قيادة بلاده وجعلها عظيمة من جديد. رافع شعار «أمريكا أولاً» لا يقرأ إلا لغة الأرقام. عبَّر عن سعادته الكبرى وهو في طريق العودة إلى العاصمة الأمريكية بأنه حصل على 4 تريليونات دولار في 4 أيام، وبالتالي ليس محبطاً حتى ولو لم تسر المحادثات الروسية – الأوكرانية في إسطنبول كما كان يأمل، والتي كان مستعداً أن يطير إليها إذا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان الأفق مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا والذهاب إلى عملية سلام.
أخذ ترامب العلاقات الاستراتيجية مع الحلفاء التقليديين في المنطقة إلى مستوى آخر. فإلى الاستثمارات القياسية، حملت زيارته رسائل سياسية تُعيد رسم ملامح «توازن ما» في المنطقة. أكَّد من الرياض على دور المملكة القيادي وتأثيرها في المنطقة، وأبدى إعجابه بما تحقَّق فيها خلال سنوات بقيادة الأمير محمد بن سلمان وغازله كثيراً. ولم يفته في الدوحة مغازلة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ولا نسي الثناء على دور أبو ظبي في الاتفاقيات الإبراهيمية التي لا تزال هدفاً سامياً لدى «سيد البيت الأبيض»، ويعتبر أنها ستكون قصة نجاح عظيمة له إذا اكتمل عنقود التطبيع، والذي تُشكِّل السعودية الرافعة الحقيقية له في العالمَين العربي والإسلامي.
مخاض التغيير
ولكن العالم تغيَّر بعد «طوفان الأقصى» وما زالت المنطقة في مخاض هذا التغيير. ففي البُعد السياسي، حيث أمل العالم بأجمعه، لا العرب وحدهم، بأن يحمل ترامب خبراً سعيداً في شأن غزة كانت الخيبة. حتى إنها لم تكن في موقع متقدِّم من كلامه. وحين أتى على ذكرها في الدوحة، التي تؤدي دور الوسيط في محادثات الهدنة بين «حماس» وإسرائيل، أثار اقتراحه بأن على أمريكا أخذ غزة وتحويلها إلى «منطقة حرية»، جدلاً من جديد، باعتباره محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين بشكل قسري. دفع ترامب بالوعود إلى المستقبل، بقوله في الإمارات إن الكثير من الأمور الإيجابية ستحدث في غزة خلال الشهور المقبلة، وإن العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة، وسنجد حلاً للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك… نُفكِّر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر.
ولم يكن قد غادر المنطقة حتى أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة تحت مسمى «عربات جدعون»، أقرب إلى اجتياح شامل للقطاع، بهدف دفع سكان شمال ووسط القطاع إلى النزوح نحو رفح، ثم إلى خارج القطاع، إما باتجاه مصر أو إلى أقصى جنوب صحراء النقب، في أكبر عملية تهجير قسري جماعي في التاريخ الحديث، حسب المتابعين. ولا يُراهن في هذا الإطار على الكلام الممتلئ بالأوهام عن توتر العلاقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستثناء تل أبيب من الزيارة إلى المنطقة.
الاختراق الحقيقي الذي حصل في هذه الزيارة، والذي يمكن النظر إليه على أنه إنجاز سياسي، هو القرار المتعلق برفع العقوبات عن سوريا، والذي شكَّل مفاجأة أكثر من المتوقع زاد من زخمها لقاء ترامب بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. باع ترامب هذا الإنجاز للأمير محمد بن سلمان، وإن كان كل من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والإمارات وقطر قد لعبوا دوراً أيضاً لرفع العقوبات. التقى الشرع في الرياض ترامب بحضور بن سلمان ومشاركة هاتفية من قبل اردوغان. تحوَّل قرار رفع العقوبات عن سوريا ولقاء ترامب – الشرع إلى الحدث الأكبر خلال زيارة ترامب. ويُعدُّ منعطفاً تاريخياً يؤسِّس لانتقال سوريا من المعسكر الشرقي إلى الدخول في عصر العلاقة مع الغرب مع ما يحمله من تحولات جيوسياسية، ويتطلب إعادة النظر بدور دمشق في الجغرافيا السياسية الإقليمية. وبدا واضحاً أن الملف السوري وُضع على نار حامية، ولا سيما أن لقاء أنطاكيا بين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث في خريطة طريق لمسار العلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق لكيفية خروج سوريا من العزلة إلى رحاب النظام العالمي، وكيفية تعاملها مع جملة المطالب الأمريكية، والتي يأتي من ضمنها ملف المقاتلين الأجانب، ومحاربة «داعش»، وملف «قسد»، وإدارة العلاقة التركية – الإسرائيلية في سوريا، وحماية كل المكونات السورية ومشاركتها في الحكم. والأهم ملف التطبيع بين سوريا وإسرائيل.
وستكون لعودة سوريا إلى الحضن العربي، وتحوُّلها الاستراتيجي، انعكاسات كبيرة على دول الجوار، من إسرائيل إلى الأردن والعراق ولبنان الذي حضر في أجندة ترامب في الرياض، حيث اعتبر أنه أمام فرصة تاريخية للتحرُّر من قبضة «حزب الله، مشدداً على أن أي دعم دولي للبنان سيكون مشروطاً بحصر السلاح بيد الدولة. ومضيفاً بالقول: «أسمع أن الإدارة الجديدة في لبنان محترفة وتريد الأفضل، نحن مستعدون لمساعدة لبنان على بناء مستقبل مع جيرانه، وعلى إقامة السلام معهم»، معتبراً أن «حزب الله» نهب الدولة اللبنانية وجلب البؤس إلى لبنان، وأن إيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تُسمى «باريس الشرق الأوسط». وكرَّر ولي العهد السعودي التأكيد على أن لبنان يجب أن يستعيد سيادته، وأن يكون السلاح محصوراً بيد الدولة.
في نظر المراقبين أن ترامب وبن سلمان ودول الخليج التي أعربت عن دعمها الكامل للقيادة الجديدة في لبنان إذا التزمت بالإصلاحات واستعادة القرار السيادي، ما زالت تمنح لبنان فترة سماح، لكنها ليست مفتوحة، ذلك أن القطار يسير، ومَن يتأخر، سيتخلَّف عن الصعود إليه.
يرى كثيرون أن العهد الجديد بدأ يأكل من رصيده داخلياً وخارجياً، وأن قوة الدفع التي حظي بها عند انطلاقها لا يمكنها أن تستمر من دون إنجازات ملموسة وفعل قوي. يحاول لبنان الاتكاء على الخارج للقيام بما يُفترض هو أن يفعل في إطار بسط سلطة الدولة على أراضيه، ويحاول تقطيع الوقت علَّ المحادثات الأمريكية – الإيرانية تأتي بنتائج إيجابية، تنعكس حلحلةً في ملف السلاح، الذي هو من وجهة نظر القيادة اللبنانية ملف إقليمي مفتاحه في طهران. ولكن مهما كانت نظرة السلطة اللبنانية الراهنة، فإن محاولة الالتفاف على ما هو مطلوب منها عربياً ودولياً يُبقي لبنان في عين العاصفة.
يدرك لبنان حجم التحولات، وقد تحدَّث رئيس الحكومة اللبناني عن «المشهد المهيب» الذي رُسم في المملكة خلال زيارة ترامب، معتبراً أن هناك «تحولاً كبيراً في المنطقة، وأن المملكة العربية السعودية نجحت في تكريس نفسها لاعباً أساسياً»، ومؤكداً أن «لا عودة إلى الوراء في حصرية السلاح»، وهو ما يؤكده على الدوام رئيس الجمهورية الذي يريد حواراً ثنائياً مع «حزب الله» حول ملف تسليم السلاح، لكن المسألة تبقى مرهونة بالأفعال لا الأقوال.
يبدو للمراقب أن في ثنايا حديث ترامب عن إيران ما يُشبه التمهيد لقرب التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
هو قال «أريد عقد صفقة مع إيران، وإذا استطعت، فسأكون سعيدًا للغاية بجعل المنطقة والعالم أكثر أمانًا. ولكن إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا، واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة أقصى درجات الضغط، ودفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، كما فعلت سابقًا». هو طلب من أمير قطر تقديم المساعدة في الملف الإيراني، وأكد أن إيران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا». ومع ذلك، أبدى استعدادًا لمنحها فرصة لمستقبل أكثر إشراقًا، وترك الخيار بيد القيادة الإيرانية. وأعاد دغدغة مشاعر القيادة الايرانية: «أريد حقًا أن تكون إيران دولة ناجحة، رائعة، آمنة، وعظيمة، لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. هذا العرض لن يبقى قائمًا إلى الأبد. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار، وليس لدينا الكثير من الوقت للانتظار».
اختُتمت زيارة ترامب إلى الخليج محمّلة باتفاقيات استثمارية من الخليج نالها كما تمنى، وبهدايا سياسية لسوريا، وفترة سماح للبنان، وتلميحات إيجابية حيال اتفاق نووي مع إيران. إلا أن الملف الفلسطيني بقي خيبة الزيارة الكبرى. فقد رُحِّل الملف برمته، إلى جانب المطلب العربي ـ الإسلامي المتعلق بحل الدولتين، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحلحلة.
ترك ترامب للسعودية حرية اختيار توقيت التطبيع مع إسرائيل، إلا أن المعاهدة العسكرية لم تُستكمل، ولم تُطرح علنًا أي تفاصيل بشأن البرنامج النووي السلمي السعودي. وكأنما أراد ترامب أن يسير نصف خطوة فقط بعيدًا عن إسرائيل، مكتفيًا بتأكيد موقع السعودية لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، وشريكًا استراتيجيًا لواشنطن، لكنه لم يتمكن ـ أو لم يرغب ـ في اتخاذ الخطوة الكاملة.
الصفقة الكبرى، على ما يبدو، لم يحن أوانها بعد.
القدس العربي
———————————
إدارة الشرع مثقلة بالمقاتلين الأجانب… وخطر عودة تنظيم «الدولة»/ منهل باريش
18 أيار 2025
عادت قضية المقاتلين الأجانب في سوريا إلى الواجهة بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، حيث طرح ترامب على الرئيس السوري الانتقالي، خمسة شروط (لا ثمانية كما في السابق) أبرزها مطالبته بترحيل المقاتلين الأجانب وإبعاد من وصفهم بـ«الإرهابيين الفلسطينيين» من سوريا، والمقصود بهم حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وباقي التنظيمات الفلسطينية المسلحة. بالإضافة إلى ذلك يأتي شرط مساعدة أمريكا على منع عودة تنظيم «الدولة الإسلامية» وتسليم غدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرق سوريا إلى السطات في دمشق.
واكتسب الأمر أهمية أكبر بعد تهديد إعلام التنظيم الرئيس الشرع، فقالت افتتاحية صحيفة «النبأ» الناطقة باسم التنظيم إنه نقض «ملة ابراهيم» واستبدلها بـ«اتفاقيات إبراهام»، في إشارة إلى عرض ترامب ضم سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
واتهمت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد على لقاء الرئيسين، الشرع بأنه يسعى إلى «التخلص من المقاتلين الأجانب بحسب الاملاءات الأمريكية»، مشيرة إلى انه «استطاع في النهاية أن يفكك جماعاتهم -مستقلين وغير مستقلين – وينهي مشروعهم الذي طوعه لخدمة مصالحه دهرا». وذكرت الصحيفة المقاتلين الأجانب بأنهم لم يسمعوا نصائح قادة «الدولة الإسلامية»، وهم يدفعون الثمن.
ومن غير المرجح أن تلاقي دعوة التنظيم صدى في أوساط المقاتلين الأجانب، فبعضهم شارك في القتال ضد التنظيم إلى جانب «جبهة النصرة» وآخرون تجنبوا ذاك القتال وامتنعوا عن الالتحاق به في عز انتصاراته وتوسعه في سوريا والعراق. كما أن غالبية المقاتلين الأجانب الذين بقوا في سوريا خبروا طعم الحياة في الحواضر الريفية وأسسوا شبكات كبيرة من المصالح في الشمال السوري وهؤلاء غير مستعدين للتخلي عن حياتهم واللجوء إلى الكهوف والصحاري مرة أخرى.
ولكن في المقابل، ليس من المبالغة القول إن ملف المقاتلين الأجانب يعتبر اليوم بين الأكثر تعقيدا بالنسبة للسلطة السورية الجديدة وعبئاً حقيقياً عليها. فعلى رغم التحولات الكثيرة التي شهدتها «هيئة تحرير الشام» لغاية وصولها إلى السلطة وانتقالها من تنظيم جهادي يوالي القاعدة إلى تحالف عسكري يضم غالبية الطيف المسلح المعارض، إلا أنها اعتمدت فعلياً وبشكل كبير على المقاتلين الأجانب (المهاجرين) في تثبيت سلطتها على مناطق الشمال السوري في مراحل الاقتتال مع بقية الفصائل، ثم للوصول إلى ما وصلت إليه بدخولها دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
إنذارات وتوقيفات
في الأيام القليلة الماضية سارعت الإدارة السورية إلى إنذار عدد من المقاتلين الأجانب النشطين على وسائط التواصل الاجتماعي بضرورة الامتناع عن الظهور بصفة عسكرية. وعلمت «القدس العربي» من مصدر عسكري مطلع أن القيادة السورية الجديدة «طلبت من بعض المقاتلين الامتناع عن الظهور باللباس العسكري والتحدث بصفتهم مقاتلين في الجيش السوري». وأضاف المصدر أن القيادة «خيرتهم بين الالتزام بتعاليم المؤسسة العسكرية وضوابطها أو مغادرتها والظهور بصفة مدنية دعوية» وعزت القيادة أسباب ذلك التحذير بالتسبب في «إثارة النعرات الطائفية» بين مكونات الشعب السوري، حسب المصدر العسكري. وزاد أن القيادة أبلغت عددا من المقاتلين الأجانب ومنهم أبو دجانة التركستاني ضرورة الامتناع عن نشر صور أو مقاطع مصورة له بالزي العسكري، علماً أن التركستاني هو أحد عناصر الحزب الإسلامي التركستاني الذين نشروا صورا على وسائط التواصل الاجتماعي يهددون فيها الأقليات السورية.
بالتوازي، أكد مصدر أمني سوري اعتقال القيادي في «هيئة تحرير الشام» شامل الغزي أبو خطاب قبل عدة أيام على خلفية «التحريض على الأقليات السورية على وسائط التواصل الاجتماعي». ونفى المصدر أن يكون لاعتقاله أي علاقة بملف «المقاتلين الأجانب» لافتاً إلى أنه جرى «تنبيه الغزي في وقت سابق بوقف نشاطه والالتزام بالتعليمات العسكرية، لكنه استمر».
في المقابل نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا الأخبار المتداولة عن بدء اعتقال السلطات السورية أي من المقاتلين الأجانب في سوريا، واصفاً تلك الأخبار بأنها «مضللة». وأكد في تصريح رسمي أن وزارة الداخلية أو مؤسساتها الأمنية لم تنفذ مثل هذه الحملة في إشارة إلى انتشار معلومات حول تضييق واعتقال لمقاتلين أجانب في إدلب وحماه. كذلك نفى أن يكون ما يجري على علاقة بأحداث الساحل.
وفي حين ليس واضحاً بعد كيف ستتعامل حكومة الشرع مع هذا الملف الشائك، إلا أن الأكيد إن السنوات الخمس الماضية كانت محطة اختبار كبيرة له ولجماعته في التعاطي الدولي لا سيما بالشأن الأمني. فقد تعلم سريعاً من تجربته وقضى على كثير من التنظيمات الجهادية التي حاولت بناء تحالف يهدد كيانه وسلطته في إدلب، وقام بتفكيك تلك الجماعات ترغيبا وترهيبا وحربا حتى أعلنت استسلامها وقبلت بسلطته.
لذا، من المرجح أن ينتهي ملف المقاتلين الأجانب عبر «حل سلمي» ومن المستبعد خوض صراع كبير معهم، وذلك لعدة أسباب، أولها أن أغلب الجماعات الأجنبية المقاتلة هي جماعات صغيرة جداَ، باستثناء مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني «الايغور» الذين يشكلون القوة الأبرز في الجماعات الجهادية الموالية للشرع والباقية في سوريا. وفي حين تتضارب المعلومات عن أعداد مقاتلي الحزب، الذين قدرتهم مجلة «فورين بوليسي» بنحو خمسة آلاف مقاتل، وأن عددهم الإجمالي مع عوائلهم نحو 15 ألفا، تقاطعت معلومات لـ«القدس العربي» حول أن عددهم لا يتجاوز 1500 مقاتل في أحسن الأحوال.
وكان أبو محمد التركستاني ظهر خلال أحداث الساحل السوري في أذار (مارس) الماضي على طريق اللاذقية ـ طرطوس إلى جانب عشرات المقاتلين الإيغور والسوريين. وخلال شهر نيسان (ابريل) أبعدت وزارة الدفاع السورية الفرقة التركستانية عن الساحل السوري لمنع مقاتليها من ارتكاب أية انتهاكات هناك ضد العلويين وأعادت نشرها على الطريق الواصل بين حمص وطرطوس لضبط الحدود ومنع عمليات تهريب السلاح والكبتاغون من لبنان وإليه.
والجدير بالذكر أن الشرع منح التركستاني، واسمه عبد العزيز داوود خدابردي التركستاني، رتبة عميد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، وهو يقود الفرقة 133 في الجيش السوري الجديد، ضمن عدد من الترفيعات العسكرية التي أجراها الشرع.
وحالياً تتجنب وزارة الدفاع السورية إضافة المقاتلين الأجانب إلى ذاتية الفرقة والألوية وخصوصا المقاتلين العرب، في إشارة واضحة إلى أن الإدارة الجديدة بدأت تنظر لهم كمشكلة يجب التعاطي معها بجدية وعدم تجاهل ضمانة الأمير محمد بن سلمان والرئيس اردوغان لتنفيذ مطالب ترامب. ومن المرجح أن تلعب تركيا دورا كبيرا في هذا الملف، من خلال تسهيل عودة المقاتلين الأجانب والمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لهم في بعض الدول.
المغادرة خارج سوريا خيار قد ينطبق على مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني القادمين من تركيا والذين أقاموا فيها سابقاً. أما القادمون من جنسيات أجنبية فقد يكون أحد الحلول العملية إبعادهم عن مراكز القوة العسكرية ومحاولة توفير خيارات أخرى لهم للعيش كمدنيين وتسهيل إقامتهم، سواء من خلال تجنيسهم كمواطنين سوريين، وهذا الخيار قد يلاقي معارضة شديدة من جمهور كبير من السوريين، وقد يشجع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على المطالبة بتجنيس بعض قادتها وعناصرها من غير السوريين أو من خلال منحهم إقامات وتقديم ضمانات لهم للبقاء ومنحهم حقوقهم في الحياة والعمل وإبعادهم عن الموسسة العسكرية والأمنية.
إضافة إلى ذلك فإن الفلسطينيين السوريين يرغبون بالحصول على الجنسية أيضا ومعهم عشرات آلاف السوريات المتزوجات من مقاتلين أجانب وبمنح جنسيتهن لأزواجهن وأولادهن ويطالبن بها منذ سنوات طويلة.
قسد و«سجون داعش»
أما في شرق سوريا، فقد أدت شروط ترامب الأخيرة بنقل سجون «داعش» من إدارة «قسد» إلى إدارة الشرع، إلى إضعاف نفوذ المقاتلين الأكراد الذين يشكلون الشركاء المحليين الفعليين في «التحالف الدولي للقضاء على داعش». ولطالما شكلت سجون عناصر التنظيم أقوى أوراق القوة بيدهم، وجعلت واشنطن تمانع رغبات تركيا الدائمة في القضاء على وحدات «حماية الشعب» باعتبارهم الذراع السوري من حزب العمال الكردستاني التركي. ولا شك إن الخطوة هذه ستخفف من الإنفاق الأمريكي المباشر على تلك السجون، ويرجح أن تحل السعودية محلها في تحمل تكلفة الرعاية في تلك السجون.
كذلك، تسعى واشنطن إلى الاعتماد على الإدارة السورية في القضاء على خلايا التنظيم النشطة على تخوم البادية السورية وفي عمقها، وهذا يعني تعاونا أمنيا ورقابة أمريكية إلى حد كبير على الأجهزة الأمنية السورية. وتعزز هذه الشراكة المحتملة أدوار أكبر للتعاون بين الدولتين وتفتح أبواب التعاون الأمني في ملفات أخرى بما يمنع عودة إيران والحد من نشاط حزب الله.
القدس العربي
——————————-
طريق دمشق إلى واشنطن عبر الرياض/ إبراهيم حميدي
آخر تحديث 18 مايو 2025
كانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض، محطة مفصلية تسجل في كتب التاريخ ضمن الزيارات التي تترك آثارا كبيرة في مستقبل المنطقة وصوغ النظام العالمي الجديد، لما تضمنته من تفاهمات واتفاقات اقتصادية ودفاعية وعلمية وصفقات تخص الذكاء الاصطناعي.
والمفاجأة الكبيرة من ترمب، خلال زيارته التاريخية، كانت إعلانه رفع العقوبات المفروضة على سوريا واستعادة العلاقات معها، ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برعاية ودعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أي إن طريق دمشق للخروج من العزلة الدولية التي فرضتها واشنطن عليها لعقود طويلة يمر من الرياض بوزنها ودورها المحوري في الإقليم والعالم.
وعليه، شكل لقاء الرياض قطيعة مع عقود من العزلة والحصار اللذين فرضا على سوريا بسبب سلوك النظام السابق على شعبه وجواره وتحالفاته الإقليمية. إذ إن سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، هو أوسع من تغيير نظام سياسي. وكان حدثا استراتيجياً هو الأهم في الشرق الأوسط منذ عقود. ومثلما شكّل سقوط نظام صدام في 2003 تقدما أساسيا لـ”الهلال الإيراني” في الإقليم، فإن سقوط نظام الأسد في 2024، كان محطة في تدحرج نكسات “الهلال”. وكما كان انحياز سوريا إلى طهران عامل ترجيح لـ”محور الممانعة” في الإقليم، فإن عودتها إلى الحضن العربي يشكل تحولا استراتيجياً في ميزان القوى الإقليمية.
لا شك أن سوريا بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها وإمكاناتها، تشكل قاعدة أساسية لبناء الهيكل الإقليمي الجديد والعلاقات العربية. ويجوز القول إنها بمثابة حجر الزاوية في بناء الشرق الأوسط الجديد. إنها الهزيمة الأكبر التي تتعرض لها إيران منذ “الثورة” في 1979 وتحالفها مع نظام الأسد-الأب، ثم الأسد-الابن. كما أن تثبيت الهزيمة الاستراتيجية لإيران يأتي من سوريا.
ولا شك أن رهان طهران كان على استدامة الحصار والعقوبات لدفع الأمور إلى الانفجار والفوضى وانتعاش “داعش” على أمل استعادة بقايا النفوذ. وعليه، فإن قطع الطريق على ذلك يكون بالعمل على توفير أسباب استقرار سوريا من بوابة إخراجها من الثلاجة الاقتصادية ورفع سيف العقوبات عن رقبتها.
صحيح أن الطريق إلى سوريا الجديدة لا يزال طويلا سواء ما يتعلق بتوضيح كيفية وحدود رفع العقوبات أو تخفيفها من جهة، أو ما يتعلق بإعمار سوريا وتوفير الأموال الطائلة لذلك من جهة ثانية. لكن المفتاح كان اتخاذ قرار سياسي برفع العقوبات، وهذا ما فعله ترمب، أي تحديد اتجاه القطار ومحطته النهائية.
بات الموضوع الآن في أيدي المفاوضين السوريين والأميركيين. إذ إن واشنطن حددت بعض المطالب من دمشق تتعلق بالمقاتلين الأجانب، ومحاربة الإرهاب و”داعش”، وطرد التنظيمات الفلسطينية “أدوات” النظام السابق، وتدمير السلاح الكيماوي، والانضمام إلى اتفاقات السلام مع إسرائيل. كما أن دمشق وضعت على مائدة التفاوض توقعاتها من أميركا المتعلقة بالمساعدة في بسط السيادة السورية على كامل الأراضي، والتعاون الفني في تدمير السلاح الكيماوي، ودعم جهودها لتوفير الأمن في الجنوب وتحييد التوغلات الإسرائيلية، إضافة إلى تبادل المعلومات الأمنية لمحاربة “داعش”.
في سوريا الآن، سباق بين مسارين: مسار رفع العقوبات وتدوير عجلة البناء والاستقرار في سوريا وما وراء الحدود، ومسار بطء الماكينة الأميركية في الإفادة من الدينامية السياسية وبروز العراقيل وفيضان المشاكل إلى الجوار. من مصلحة سوريا والإقليم والشرق الأوسط، توفير أسباب نجاح سريع للمسار الأول.
المجلة
——————————
عندما تخذُلنا الركاكة السياسية/ مازن علي
18 مايو 2025
لأن السياسة ليست اختياراً طوعياً يمكن الابتعاد عنه أو تجنّبه، ولأن السياسة تحدّد مستوى التعليم والطبابة التي نتلقاها، بل جودة الهواء الذي نتنفّسه، ولأنها تتدخّل في شروط الحياة، بدءاً من أدنى الحاجات إلى أعمق معاني المواطنة والحرية، فإننا لا نستطيع الإفلات منها ومن تأثيرها على واقعنا ومصيرنا، تماما كما لا نستطيع الإفلات من المناخ الذي نعيش فيه، على حد تعبير روبرت دال. لهذا؛ عندما تختلّ السياسة أو تتعطّل، لا يظل أثرها حبيس الجدل النظري، بل يلقي بثقله على تفاصيل الحياة اليومية.
هذه مقدّمة مبسطة ومختزلة لمعنى السياسة التي تصفع وجوهنا بتداعياتها وانعكاساتها على واقعنا مع كل تصريح أو قرار يصدر عن السلطة السورية الحالية، فبعد مرور نحو ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، تستخدم السلطة خطاباً سياسياً ينطوي على وعود مُعلّقة التنفيذ، وإجراءات غير قابلة للصرف السياسي، شهدنا تجلياتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنجز على عجل، في مشهد بروتوكولي أكثر منه آلية حقيقية لإنهاء الصراع أو الاستماع إلى المكوّنات المتضرّرة. مثله، الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر من دون مشاوراتٍ مجتمعية كافية، وأهمل المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي؛ كالمشاركة السياسية والتمثيل العادل. سبق ذلك تسريح آلاف الموظفين تحت ذرائع الفلول أوالعمالة الزائدة، من دون البحث في تداعيات ذلك على مؤسّسات الدولة، وما تُحدثه من توترات اجتماعية بمظلومية مضافة إلى الجرح السوري لتبقيه مفتوحاً، ما عزّز الريبة في دوافع السلطة الجديدة.
أضف إلى ذلك إعادة إنتاج شبكة زبائنية جديدة من المحسوبين على دوائر السلطة، في التعيينات والترقيات، وجدل المقاتلين الأجانب، ما أفرغ الوعود من محتواها، وأعاد تدوير النخبة الوافدة إلى دمشق بعد إسقاط نظام الأسد، بدل فتح المجال أمام الطاقات الوطنية المعطّلة في المؤسسات الأصيلة، ثم جاء تأليف الحكومة تحت يافطة التكنوقراط، لتؤكّد أن أداء السلطة يركز على إدارة الصورة، لا بناء الثقة، واستثمار رمزية التحرير لتبرير احتكار القرار، عبر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس المرحلة الانتقالية.
لا يُراد من كل ما سبق التحامل على التجربة الوليدة في سورية، ولكن ما نعايشه مع السلطة ليس مجرّد ضعف في الأداء، بل صورة أوضح لما يمكن تسميتها الركاكة السياسية، التي لو أردنا تعريفها لفهمناها انطلاقاً من كنايتها اللغوية وإسقاطاتها السياسية؛ فكما أن للّغة أصولاً تضبط المعنى وتمنح العبارة تماسكها، فإن للسياسة منطقاً يحكم الفعل ويمنعه من التشتت والتناقض. والركاكة، في أصل معناها اللغوي، ليست خطأ صريحاً بقدر ما هي ضعف في التكوين؛ جملة لا تعرف أين تبدأ وأين تنتهي، كلمات مترابطة شكلياً، لكنها لا تحمل فكرة واضحة. وعلى هذا القياس، تبدو الركاكة السياسية شبيهة بسابقتها، لا تنفي النية الطيبة، ولكنها تكشف عن افتقار إلى الحنكة، والحكمة في اتخاذ القرار. ليست الركاكة هنا فعلاً متعمّداً، بل ارتباكٌ وتلكؤٌ يتنكّر في هيئة الحذر، لكنها، في النهاية، تُنتج الأثر نفسه؛ تآكلاً في المعنى السياسي، وعجزاً عن بناء جملة مفيدة اسمها الدولة.
قد يعطي بعضهم العلامة الكاملة لنجاح السلطة في تسجيل اختراقات على مستوى الدبلوماسية الدولية؛ كالحصول على تعهد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات، التي أثقلت كاهل الشعب السوري، ولكن لا ينبغي أن يُنسى أنها ثمرة جهد هائل بذلته دول إقليمية، وتحديداً الأشقاء العرب في سبيل ذلك؛ لهذا يُعدُّ نسب هذا النجاح إلى كفاءة السياسة الخارجية للسلطة تعبيراً عن ركاكة سياسية مضاعفة، فكلنا يعرف أن المصالح لا تُمنح بتعهد لفظي، ولا تُبنى عبر المجاملات الدبلوماسية، بل تُشتق من الداخل، ومن تماسك المشروع الوطني.
التهافت خلف الاعترافات الخارجية، وتقديم تنازلات لا يعلم المواطنون كلفتها، ولا مواضع المقايضة فيها، يشي بمسار تفاوضي غير شفاف، ويقوض جوهر السياسة التي يفترض أن تكون شأناً عاماً، لا ساحة مغلقة لصفقات النخبة.
الأهم أن محاولة التوفيق بين أطراف دولية كبرى تختلف مصالحها وتتناقض طلباتها تشبه السير في حقل ألغام من دون خريطة وطنية، فمن الصعب، بل المستحيل، إرضاء واشنطن وموسكو وأنقرة وباريس والعرب وغيرهم في آنٍ معاً، من غير تقديم أثمان سيادية أو إيجاد تناقضات داخلية عميقة، بالنظر إلى قائمة الشروط التي قد تفجر السلطة ذاتها. السياسة هنا تتحول إلى حقل توازنات هشّة، لا إلى مشروع واضح لبناء الدولة من الداخل. في حين أن المسار الطبيعي لأي سلطة محمّلة بإرث ثوري، يفترض أن تنطلق من قيمها وشعاراتها التي خرج السوريون من أجلها، بدل البحث عن شرعية خارجية قد تُمنح اليوم وتُسحب غداً.
ما نراه اليوم من أداء السلطة الانتقالية في دمشق ليس سوى امتداد واضح لتلك الركاكة؛ فهي لا تمارس القمع، ولكنها توحي به. لا ترفض الديمقراطية، ولكنها تُسوّف بحجة الوقت، وحساسية المرحلة. ربما ليست مسوّغات خاطئة تماماً، لكنها تبريرات تنمّ عن الافتقار إلى الدربة والمهارة السياسية. تحاول تجنّب الاصطدام بالمطالب والاستحقاقات الملحّة، فإذا بها تصطدم بالواقع. فالأمن ينفلت، والثقة تتآكل، والمجتمع الذي يمنح المقبولية والشرعية يتسلل إليه الخذلان.
لو قُيّض لأهل السلطة فهم أصيل وراسخ للسياسة، لما كنّا أمام جدل بديهيات الحكم والإدارة والمشاركة والتمثيل، بل كنّا نحث الخطا إلى رسم ملامح الدولة المنشودة، المعبّرة عن الإرادة العامة للسوريين، وشكل النظام الذي يوجه السياسات، ومنها يمكن الانطلاق نحو بناء استراتيجية خارجية تلبي مكانة سورية الحضارية وموقعها الجيوسياسي والاستثمار بهما، لتجاوز السنوات المهدورة في عهد النظام البائد.
العربي الجديد
—————————-
المجلس التشريعي الغائب/ عبسي سميسم
18 مايو 2025
لا تزال الحكومة السورية تدير شؤون البلاد وفق قوانين النظام السابق، ووفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري من تعديلات، دون أن تتمكن هذه السلطة من التعاطي مع القضايا التي تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، بسبب عدم وجود سلطة تشريعية تصادق أو تسنّ قوانين تتماشى مع الواقع الجديد. هذا الأمر أدّى إلى إصدار العديد من القرارات المخالفة للدستور السابق، ولا تستند إلى شرعية قانونية مستمدة من سلطة تشريعية، كما أدّى عدم وجود سلطة تشريعية إلى تعطيل جزئي لعمل السلطة القضائية، التي لا تزال تقف عاجزة عن حلّ الكثير من القضايا التي تتطلب قانوناً يستند إلى مرجعية تشريعية.
كما لا يزال هذا الفراغ التشريعي يشكّل إرباكاً لمعظم مفاصل السلطة التنفيذية بسبب عدم وجود سند قانوني للكثير من القرارات التي ستتخذها، علماً أن الرئيس أحمد الشرع، ومنذ تعيينه رئيساً لسورية من قبل غرفة العمليات العسكرية المشتركة ضمن خطاب النصر الذي ألقاه العقيد حسن عبد الغني في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن هذا المجلس لم يجد طريقه إلى النور رغم الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للشرع بطريقة تشكيله، سواء لناحية طريقة اختيار الأعضاء، أو عددهم، أو توزعهم المناطقي.
ولكن رغم كل الملاحظات على هذا المجلس، فإن إقراره يشكل ضرورة أكثر من ملحة في المرحلة الحالية، وخصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، والذي يتطلب من الجانب السوري تغييرات جذرية في القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبالسياسات المالية والسياسات النقدية، والقوانين المرتبطة بحركة التجارة من استيراد وتصدير وحركة النقل بالعبور “ترانزيت” وغيرها من القطاعات التي سترفع عنها العقوبات ويتطلب تفعيلها سن قوانين جديدة تحتاج إلى مصادقة هيئة تشريعية، تسنّ من خلالها تلك القوانين. وبالتالي يجب على الرئيس السوري أن يسارع إلى تشكيل المجلس التشريعي الذي أقرّه منذ نحو أربعة أشهر، وعلى كل القطاعات الاقتصادية في البلاد أن تعمل على تهيئة بنية قانونية تؤسس لواقع جديد في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، بدلاً من الانتظار، ومن ثم أخذ دور المتفاجئ من التطورات التي تحصل.
العربي الجديد
———————————–
ما بعد زيارة ترامب/ محمد أبو رمان
18 مايو 2025
أكبر فائز من زيارة الرئيس الأميركي ترامب الخليج العربي، الأسبوع الماضي، سورية، إذ أعلن تجميد العقوبات وتخفيفها على سورية (هنالك فرق بين التجميد والإلغاء والتخفيف؛ مرتبط بما يتعلق بقوانين أميركية، لكن التجميد مؤقتاً خيار جيد للاقتصاد السوري)، ولا في القول إنّ لهذا التوجّه، بانتظار تطبيق القرار على أرض الواقع، أهمية سياسية بقدر ما له أهمية اقتصادية وجودية لاستقرار سورية في المرحلة المقبلة.
على الصعيد السياسي، هذا القرار بمثابة فك ارتباط، ولو إلى حين، بين المنظور الأميركي لسورية وأجندة بنيامين نتنياهو، الذي حاول مرّاتٍ بصورة شخصية وسلوكية عبر العدوان العسكري المباشر، وعبر اللوبي الصهيوني، وحتى من خلال تيار في الإدارة الأميركية، أن يقنع ترامب بأنّ النظام السوري الحالي خطير، وأنّ ما تقوم به إسرائيل وما تحاول القيام به من خلال اللعب بورقة الأقليات يخدم المصالح الإسرائيلية والأميركية.
الأردن وقطر قاما بدور مهم في التطبيع الدبلوماسي لصالح النظام السوري، والدور الأبرز مع إدارة ترامب كان للسعوديين والأتراك، الذين شكّلوا تحالفاً إقليمياً مهمّاً لدعم سورية، وتمكين الدولة أن تنهض من جديد وتفويت الفرصة على مخطّطات التقسيم والفوضى، فرفع العقوبات بمثابة منح شرعية سياسية أخرى للنظام الجديد وتمكين له، وإضعاف الأصوات في الداخل والخارج التي كانت تراهن على إسقاط النظام والتقسيم، فهي اليوم محدودة وعاجزة في الداخل أولاً وهذا المهم، ودوران عجلة الاقتصاد، وإن كان الأمر سيكون بطيئاً في البداية، سيساعد على تعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي.
لن ينفكّ نتنياهو في محاولة إطاحة الدولة، واستثمار الفرصة، وعلى الأغلب سيستخدم أدواته المختلفة في أروقة البيت الأبيض واللوبي الصهيوني لتنفيس قرار ترامب أو محاولة ربطه بشروط معينة. وفي النهاية، لن يقبل نتنياهو إلّا بسورية ضعيفة هشّة، بلا جيش قوي، وغير قادرة على الدفاع عن نفسها تجاه هذه الهمجية الإسرائيلية.
من الواضح أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وفريقه يدركون جيداً الاختلال الكبير في موازين القوى الخارجية، وأهمية التركيز على الوضع الداخلي، ويراهنون كثيراً على الأدوار العربية والتركية في دعم الدولة، ويتجنّبون أي صراع مع إسرائيل شراءً للوقت وتفويتاً لأجندة التقسيم التي يؤمن بها الفريق اليميني حول نتنياهو. لذلك المعركة لم تنته بعد في الكواليس الأميركية، وإن كان الموقف الأوروبي داعماً قوياً للنظام الجديد من الضروري استثماره.
من جهةٍ أخرى، باء الرهان المبالغ فيه الذي عززته تقارير وتسريبات إعلامية أميركية وإسرائيلية على موقف أميركي حاسم في ما يتعلّق بنتنياهو وبوقف العدوان على غزّة وبالحل السياسي بفشل ذريع، ولم يكن واقعياً في الأساس، لذلك وبالرغم من إفراج حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي الإسرائيلي- الأميركي، عيدان ألكسندر، لم يؤد إلى انفراج، فما يزال نتنياهو متمسّكاً بخطّته “عربات جدعون” لتهجير أهل غزّة، عبر توسيع العملية العسكرية، وفرض واقع جديد، لاستباق ضغوط ترامب، إن كان هنالك ضغوط.
لا تبدو مؤشّرات على تغير جذري وجوهري في موقف ترامب تجاه غزّة، وما تتناقله تلك التقارير مبالغ فيه، في رأي الكاتب، وإن كان هنالك خلاف على أكثر من صعيد بينه وبين نتنياهو، فإنّ بعض تصريحاته خلال زيارته الخليج، أظهرت أنّه ما يزال متمسّكاً بخطة التهجير، عبر الحديث عمّا أطلق عليه “أرض الحرية” في غزّة، وهو مشروع يستبطن التهجير بوضوح؛ بل صعّدت إسرائيل من عملياتها وقصفها في غزّة والضفة الغربية في نهاية جولة ترامب الخليجية، ما يؤكّد عدم وجود تغيير جوهري، حتى اللحظة، في موقف الإدارة الأميركية.
ماذا عن المرحلة المقبلة؟ على الصعيد السوري؛ المطلوب عربياً- تركياً البناء على موقف ترامب الجديد، ومتابعة الموضوع، ودعم سورية. وعلى صعيد غزة من الضروري تكثيف الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الإبادة الكاملة لأهل غزّة، فإسرائيل ستصعّد كثيراً من الناحية العسكرية، وسيحاول نتنياهو الخروج من المأزق الحالي عبر قدر أكبر من استخدام القوة العسكرية وتفويت الفرصة على خصومه في الداخل لاستثمار الإفراج عن عيدان.
العربي الجديد
———————————-
سورية… توازن العلاقات الدولية/ فاطمة ياسين
18 مايو 2025
لم تعلن الإدارة الأميركية بشكل حاسم عن نيّة الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سورية حتى اختار الرجل طريقة درامية لإعلان القرار، عندما كان يلقي خطاباً في الرياض أمام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وفي حضور كثيرين. ولم يكتف ترامب بالإعلان، بل أزال كل ما كان يثير الجدل بشأن شخصية الرئيس السوري أحمد الشرع عندما قابله في اجتماع جمعهما مع ولي العهد، وانضم إليهم عبر الهاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهناك في تلك القاعة، ذاب كثير من الجليد الذي تراكم بين سورية وأميركا طوال عقود ترجع إلى ما قبل زمن الوحدة مع مصر. وفي الاجتماع بالذات، كانت إشارة البدء قد انطلقت نحو شكل آخر من التحالفات التي ستغيّر اللون السياسي للإقليم. كان الشرع قد صرح بوضوح بأن لا مكان لوجود إيراني من أي نوع في سورية، وهو هدف منشود لدى الولايات المتحدة، وإسرائيل بشكل خاص، ومن ثم قد يصبح الوضع مهيأ للتحدّث بشأن الوجود الروسي في سورية، حيث لا تزال قاعدتان عسكريتان روسيتان في الساحل… لم تُخفِ حكومة الشرع نيات إرساء السلام، وخصوصاً في ظل عدم امتلاكها جيشاً متماسكاً بعد، وقد لا يتجاوز الدور الإسرائيلي في الجنوب تأمين نفسه مع إمكانية مراقبة محيطه لرصد حالات تسلّل ممكنة، أما الدور المنتظر أن يكون قوياً ومؤثّراً فهو الدور التركي.
ما تحتاجه سورية بالفعل التعاون مع تركيا، نظراً إلى ما يحمله الأتراك من إرث تنموي طويل وبشكل خاص خلال الفترة الأردوغانية التي حققت خطواتٍ اقتصادية وسياسية مهمّة. ونظراً إلى التاريخ المشترك الطويل الذي عاشه البلدان، وتداخلت فيه الجغرافيا بالسكان. وإذا أعيد بناء المؤسسات السورية على أسس جديدة بإشراف تركي، وخاصة المؤسّسات العسكرية والأمنية وبعض هياكل الاقتصاد، يمكن أن يعتبر ذلك مكسباً سورياً حقيقياً، بالإضافة إلى الدعم التركي الجاد للثورة السورية خلال كل مراحلها، فقد استضافت المدن التركية اللاجئين السوريين، واحتضنت أكبر عدد منهم، كما كان لتركيا الدور الأكبر في تنظم المجموعات المسلحة في سورية وإبعادها التدريجي عن الفكر الجهادي، لتُظهره بالشكل الوطني المطلوب. وكانت خلف الهجوم الكبير الذي أطاح بشّار الأسد وأوصل الثورة إلى قصر الشعب، وهذه رحلة تؤهّل تركيا لتكون لاعباً أساسياً في الداخل السوري، ليس على طريقة إيران التي هيمنت على القرار السوري ودمجت سورية في خطها القتالي، إلى جانب حزب الله وبعض الجماعات العراقية، بل في تحالف واضح المعالم يحترم سيادة الدول… رغم ذلك، تبدو الموازنة مطلوبة بين مصالح دول الإقليم وخاصة في المراحل الأولى لتشكيل الدولة، ومن الجيد أن يكون للعرب دورٌ مهمٌّ أيضاً، وخصوصاً دول الخليج الثلاث التي رعت، أو رحبت، بسورية الوليدة، وسعت في إزالة العقوبات عنها، وهي تحاول حالياً تنظيم نفسها للدخول في سوق الاستثمارات السوري الذي سيدفع سورية إلى الأمام، ويمكن ضبط موازنة تحالفات تركية عربية بواسطة حكومة رشيدة.
لوحظ بوضوح غياب رئيسي لمصر عن المشهد، ولا يُعتقد أن الشرع سيتجاوز دوراً مصرياً يمكن أن يكون مهماً لإبقاء سورية منفتحة على الجميع، لا تعلن عن نفسها ضمن تكتل بعينه.. حتى العراق المربوط إلى إيران بحبل قوي يجب أن تدار العلاقة معه بحكمة إضافية، وها إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شارك في القمة العربية في بغداد. كان العراق أحد مصادر المجموعات المقاتلة التي أطالت زمن الحرب السورية، وما زالت موجودة قرب الحدود، ومحتقنة، وهذا أحد التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار، كما يجب تجاوز علاقة الشرع السابقة مع العراق كما جرى تجاوزها مع الولايات المتحدة، وذلك لاستمرار التواصل ومراقبة الوضع الأمني على الأقل. وفي النهاية، يمكن لعلاقات سورية متوازنة مع الإقليم ودول العالم أن تعبّد أمام هذا البلد طريقاً مشرقاً بعيداً عن إرث الماضي كله.
العربي الجديد
————————————–
السويداء تغادر عزلتها مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا/ أيمن الشوفي
17/5/2025
السويداء- تُبدي السويداء ارتياحا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ولا سيما بعد المرونة التي شهدتها علاقتها مع الحكومة السورية بدمشق، مع آمال أبناء الطائفة الدرزية بمقدرة الإدارة السياسية الحالية للبلاد على إعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية اقتصاديا وسياسيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر خلال زيارته الأخيرة للسعودية قبل أيام، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها “ضرورية” لمنح الإدارة السورية فرصة حقيقية تتيح لها النهوض بالبلاد.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ يوسف جربوع، إن رفع تلك العقوبات أدى إلى تغيير المزاج العام لدى أبناء المحافظة، كما أفشل الرهانات السياسية السابقة، بما فيها رهان التيار السياسي الذي كان يسعى إلى إضعاف السلطة السوريّة، أو عدم الاعتراف بها.
وفي حديث للجزيرة نت، قال جربوع “أعتقد أن الأمور في السويداء تسير باتجاه أفضل، بما في ذلك تعميق العلاقة مع السلطة المركزية، حيث تراجعت الأصوات التي كانت تطالب بالحماية الدولية للدروز في جنوب البلاد على أثر رفع العقوبات الأميركية، وعاد المجتمع المحلي إلى وعيه السياسي المعهود الذي لا يُجيز سوى الارتباط بدولتنا السورية، ومجتمعنا السوري الكبير”.
وكان الرئيس الروحي لدروز فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قد دعا، في بيان له، دروز سوريا إلى أخذ مكانتهم المستحقّة في الوطن السوري الموحد.
وجاء كلام الشيخ طريف سابقا لإعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في محاولة لرفض أي تدخل خارجي بشأن دروز السويداء، حسب مراقبين.
مزاج متفائل
يقول نجيب أبو فخر، رئيس “المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا” (تشكيل درزي)، إن المزاج العام في السويداء، أسوة بما هو عليه الحال في سوريا، سعيد جدا برفع العقوبات عن البلاد، ومتفائل أيضا بأن مستقبل سوريا سيكون أفضل.
وأضاف أبو فخر للجزيرة نت، إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعكس الموقف الدولي الجديد من الإدارة السورية الحالية، مما سيؤدي إلى إنهاء التوترات المحلية، وسدّ الطرق بوجه الفتن والمشاريع غير الوطنية التي كانت تلاقي قبولا واستساغة لدى البعض.
ورأى أن رفع العقوبات كان نتاج جهد “مكثف وذكي” من الدولة السورية، وخصوصا من الرئيس أحمد الشرع والفريق الدبلوماسي “الذي واجه اختبارا معقدا نظرا للظروف الإقليمية، والضغوطات المتعددة داخليا وخارجيا”.
وقال أبو فخر “ربما عكس لقاء الرئيس الشرع بترامب، وطريقة المصافحة والجلوس جميعُها الأنفة التي اشتاق السوريون لرؤيتها على مسؤول سوري أمام مسؤول غربي أو عربي، وهذا ما كان ملفتا للغاية”.
وحسب المسؤول، فإن مشاريع الانفصال لم يعد صوتها عاليا كما في السابق، “بالرغم من أنها لم تختفِ كليا” من المشهد السياسي. ويعتقد بأنه إن تحمّل السوريون مسؤولية خطابهم، وأبعدوه عن الإقصاء والتجييش الديني والمذهبي والمناطقي، “فسنكون حينها على أعتاب نهاية طرح مشاريع الانفصال وتغييبها عن المشهد السوري برمته”.
خطاب الهجري
في هذه الأثناء، جاء لافتا بعض المرونة والتبدّل الذي اكتسبهُ خطاب الرئيس الروحي لدروز السويداء الشيخ حكمت الهجري، في بيانٍ صدر عنه صبيحة اليوم التالي لقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
واعتبر الهجري أن “أي انتصار للوطن إنما هو انتصار لحقوق كل السوريين”، وقال في بيانه “بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعشْ جميعا كشركاء تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها وتلاوينها”.
وبرأي عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، فإن قرار رفع العقوبات عن سوريا “سينقل البلاد من حالة الفشل والانهيار إلى مرحلة بناء الدولة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي”.
وقال للجزيرة نت، إن قرار رفع العقوبات يمثّل “فرصة حاسمة” ينبغي استثمارها من أجل إعادة مسارات العملية السياسية الجارية في سوريا إلى نصابها الصحيح، ومراجعة العديد من الأسس التي قامت عليها، مع التركيز بشكل خاص على قضية المشاركة الشعبية في المرحلة الانتقالية.
ويعتقد درويش أن معظم أهالي السويداء يؤيدون وحدة البلاد، وبناء المؤسسات وفق معيار الدولة الحديثة. وبالتالي، فإنهم ضد إسقاط المرحلة الانتقالية. لكنهم “يطالبون بفتح مسار وطني جامع، يهدف إلى تقويم الانزياح والانحراف السياسي والدستوري” على حد وصفه.
تراجع الخطاب الانفصالي
ولم يستطع الخطاب الانفصالي الذي جرى ترويجه خلال الأسابيع الماضية في السويداء من المضي كثيرا أو التوسّع داخل الفضاء السياسي للدروز، كما يرى المراقبون. وأخفق دعاة هذا المشروع السياسي في تنظيم وقفات احتجاجية داخل ساحة الكرامة وسط المدينة، والتي شهدت فيما مضى انتفاضة شعبية واسعة بدأت في صيف العام 2023 واستمرت حتى سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
يقول المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، إن “المزاج العام في السويداء وطني الهوى ووجهته دمشق، وكنّا سمعنا وشاهدنا تصريحات موثّقة لمعظم القيادات الروحية والاجتماعية، ومعظم الفصائل المسلّحة في المحافظة، تؤكد على نبض أبناء السويداء الوطني بالرغم من بعض الاختلاف، وهو أمر طبيعي وصحيّ لا ينذر بأي سوء”.
وقال أبو طافش للجزيرة نت إن “المطالبة بالإدارة الذاتية أو الحماية الدولية ليست مطالب شعبية عامة، ولم تلقَ تأييدا لدى الجميع، وأبناء السويداء سيكونون سباقين إلى بناء الدولة السورية ومؤسساتها..”.
وباعتقاد المتحدث، فإن “مشكلة الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع ليست مع السويداء، فالسويداء وأبناؤها لن تكون حجر عثرة في طريق بناء الدولة الوطنية السورية القوية، الدولة الديمقراطية التشاركية التي تُعبّر عن أحلام السوريين”. وبرأيه فإن المشكلة تكمن مع بعض المجموعات غير المنضبطة، والتي ارتكبت الانتهاكات، وسببت توترا في حياة السوريين، على حد وصفه.
وأيده الأمين العام للتحالف الوطني السوري لدعم الثورة خالد جمول، الذي قال إن أغلبية المكونات في السويداء هي مع الحكومة السورية، ومع بناء دولة القانون. وأضاف للجزيرة نت أن “طلب الحماية الدولية الصادر عن بعض الشخصيات في السويداء لا يمثّل إلا مجموعة أو فئة معينة ضيّقة، وأغلبية أبناء السويداء ترفض أي تقسيم، وتميل إلى اللامركزية الإدارية غير الموسّعة”.
وشدد على أن السويداء تؤكد استمرار ارتباطها بالدولة السورية، ولا تفكر بالانفصال عنها، كما ويسود لدى دروز السويداء ارتياح بشأن المستقبل القريب، وما قد يحمله من انفراجات ملموسة على الصعيدين المعيشي والاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد شرعت بخطوات تهدف لاعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحديث الجهاز الشرطيّ والأمنيّ، مع الحفاظ على مركزيّة القرار فيه، بحيث سيتم تقسيم البلاد إلى 5 قطاعات جغرافيّة يشرف على كل منها معاون خاص لوزير الداخلية.
المصدر : الجزيرة
——————————-
شكرا سمو الأمير محمد بن سلمان/ عالية منصور
آخر تحديث 17 مايو 2025
بعد قرابة 6 شهور على سقوط بشار الأسد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المملكة العربية السعودية رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، فاجأ ترمب الكثيرين وأعلنها، لقد استمع لمطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فلم يكتف برفع العقوبات بل أعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، وفي اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات، جمع ولي العهد الرئيس الأميركي بالرئيس السوري أحمد الشرع، وانضم عبر تقنية الفيديو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاجتماع.
وفي البداية لا بد من القول إن ما حصل ليس فقط نجاحا لسوريا الجديدة، ما حصل أثبت للجميع أن السعودية لم تعد قوة إقليمية مؤثرة بل أصبحت قوة ذات ثقل دولي، تجمع الأضداد كما جمعت بين أوكرانيا وروسيا، والولايات المتحدة وروسيا، تضغط لوقف حروب بين قوتين نوويتين كما فعلت بين الهند والباكستان، ويقول رئيس أقوى دولة في العالم لولي العهد: “أنت طلبت وأنا ألبي”.
ضغط محمد بن سلمان لرفع العقوبات عن سوريا وضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي لعدم رفعها، فرفعت العقوبات، هذه ليست تفاصيل، هذا مستقبل منطقة وملايين البشر، هذا مشروع استقرار نابع من قوة، مشروع ازدهار منطقة نابع من إيمان بقدرات أهلها، وهذه فرصة لكل دول المنطقة للحاق بهذا المشروع.
ما حصل أن العالم أدرك أن نجاح سوريا الجديدة هو نجاح لهذه الرؤية السعودية، فسوريا المعاقبة حتى وإن سقط النظام الذي فرضت عليه العقوبات لن تعرف الاستقرار، والأعداء كثر.
اليوم عملت المملكة العربية السعودية ومعها تركيا وقطر لإعطاء سوريا الأمل، ولإعطاء نظامها الجديد فرصة للانتقال بسوريا من “محور الشر” الذي أدخلها فيه حافظ الأسد إلى محور الاعتدال.
فرحة السوريين لحظة إعلان ترمب رفع العقوبات عن بلادهم كانت فرحة مضاعفة، فبقدر ما فرحوا برفع العقوبات، فرحوا بموقف الأمير محمد بن سلمان الذي “صدق في ما وعد به” كما قال الرئيس الشرع في كلمته، فرحوا بهذا الاحتضان العربي لهم ودعم بلادهم، بعد أن كانت سوريا مختطفة معادية لكل محيطها.
اليوم لم تعد سوريا تصدر الإرهاب والمخدرات والمفخخات، لم تعد سوريا خنجرا في خاصرة محيطها، شعر السعوديون بذلك وشعر العرب بذلك.
اليوم نحن أمام فرصة لن تتكرر، لم يعد لدى السوريين أي ذريعة تمنعهم من الانطلاق بعملية إعادة الإعمار، إعمار الإنسان قبل الحجر، الفشل ممنوع ولا يستطيع أحد في سوريا تحمل تكاليفه.
على الإدارة السورية أن تلتفت إلى الداخل، أن تنطلق بعملية تعافي سوريا بالشراكة مع جميع السوريين، هؤلاء السوريون الذين كانوا سندا وداعما للنظام الجديد أمام العالم كله.
قال ترمب لسوريا: “أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”، وسوريا ستفعل وأهلها سينجحون، هذا ليس حلم بل هذا ما أثبتته الأحداث، فهم إذا ما أرادوا فعلوا، واليوم السوريون يريدون النجاح، يريدون الحياة والسلام، يريدون الحرية والازدهار، لقد اكتفى السوريون من الموت والحروب، وكل ما عدا ذلك تفاصيل قابلة للنقاش.
فشكرا لكل من آمن بسوريا وشعبها، وشكراً لكل من شارك بتحريرها من الخطف، وشكرا لمن منح سوريا الفرصة لتستعيد ألقها ولتظهر للعالم كل تميز… شكرا سمو الأمير محمد بن سلمان.
—————————–
إسرائيل أرادت استمرار العقوبات على سوريا/ محمود سمير الرنتيسي
2025.05.18
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا كان رفع العقوبات عن الدولة السورية والشعب السوري الذي يتطلع لمرحلة جديدة من الحرية والتعافي أمرا منطقيا واستحقاقا متوقعا، وبالفعل كانت معظم الأطراف الإقليمية والشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسها الشعب السوري تنتظر هذه النتيجة المنطقية، في المقابل كانت هناك جهة تعمل على إقناع الأميركيين بعدم رفع العقوبات عن سوريا وهي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
لقد كان استقبال خبر رفع العقوبات عن سوريا في دولة الاحتلال الإسرائيلي مختلفا عن استقباله في سوريا وفي بقية البلدان العربية والإسلامية حيث أزعج هذا الخبر حكومة الاحتلال وعلى رأسها نتنياهو لأنه بالفعل كما ذكرت التقارير مؤخرا كان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي طلب من ترامب حتى وقت قريب عدم رفع العقوبات عن سوريا، وقد استغل نتنياهو لقاءه الأخير مع ترامب في واشنطن الشهر الماضي لتكرار هذا الطلب.
لم تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي أن طلب نتنياهو وقد قالت القناة 12 العبرية أنهم في إسرائيل لا ينكرون أن نتنياهو طلب الابقاء على العقوبات على سوريا وعدم دعم الاستقرار في سوريا وتم رفض الطلب.
من الواضح أن ترامب كان له رأي آخر وهو ما يشير إلى وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في التأثير في موازين القوى بعد 7 أكتوبر. وإضافة لما سبق لم تكن إسرائيل على علم مسبق بقرار ترامب عقد الاجتماع مع الرئيس السوري في الرياض ولا بقرار ترامب رفع العقوبات، ويأتي هذا في سياق عدم علم إسرائيل باتفاق ترامب مع الحوثيين وكذلك ببدء المفاوضات مع إيران حول المشروع النووي الذي أعلن عنه ترامب في مؤتمر صحافي مع نتنياهو.
وقد قال الكاتب الصهيوني تامير هايمن نحن لسنا في الملعب بل نشاهد الدوري بانتظار انتهاء اللعبة ونلعب على الإسفلت الساخن لعبة عنيفة ومحلية ستنتهي بإصابات تلحق الجميع.
ولكن رغم كل هذا وبالنظر إلى ما يجري في غزة فإن نتنياهو يتعامل على أنه يمكن أن يسير على سياسة خاصة به حتى لو كانت نظرة ترامب مختلفة، ولهذا قام الجيش الإسرائيلي بالقصف قرب القصر الرئاسي في دمشق قبل أسبوعين من أجل تهيئة المجال للسيناريو الذي يريده في سوريا وهو سيناريو عدم الاستقرار. وقد أصدر نتنياهو ووزير الدفاع كاتس بيانا مشتركا قالا فيه “أن إسرائيل هاجمت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق وهذه رسالة واضحة للنظام السوري”. وفي تحد صارخ قال البيان أن إسرائيل لن تسمح بانتشار قوات جنوب دمشق أو أي تهديد للطائفة الدرزية.
وتزعم إسرائيل أن سياستها تجاه سوريا تأتي في إطار سياسة الردع لمنع تكون ما تصفه بأنه “التموضع العسكري المهدد”، وفي الحقيقة تريد إسرائيل نشر الفوضى والتهيئة لمزيد من عدم الاستقرار ليكون بمتناولها العبث والتصرف كيفما تشاء لأنها تعتقد في الحقيقة أن أي استقرار حقيقي في سوريا أو دول الجوار الأخرى لن يكون في مصلحتها.
لا يزال نتنياهو يحلم بتغيير الشرق الأوسط ولكنه لم ينجح في إثارة النعرات عبر دعم بعض الأقليات لنشر الفوضى في سوريا كما أنه من الواضح لم ينجح في إعاقة مسار رفع العقوبات عن سوريا وهذا يؤكد مرة أخرى أن قوة دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد كما كانت من قبل كما أن قدرتها على التأثير في الولايات المتحدة أيضا لم تعد كما كانت من قبل.
ولذلك فإن ما سبق يشدد على ضرورة التصرف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها طرف يريد تعطيل مسارات الاستقرار في كل المنطقة، ويشدد على التعامل معها من منظور أنها دولة وكيان يسير نحو مزيد من التراجع والتدهور.
————————-
بين إنقاذ النظام العلوي… وإنقاذ سوريا/ خيرالله خيرالله
الاثنين 2025/05/19
لا توجد في السياسة هدايا مجانية. من الآن، يُفترض التفكير في الثمن المطلوب من سوريا دفعه لقاء إعلان الرئيس دونالد ترامب، من الرياض، رفع العقوبات المفروضة على البلد، وهي العقوبات التي تسبب بها النظام العلوي. ترافق ذلك مع صدور بيان عن البيت الأبيض يشير إلى أن الرئيس الأميركي “حضّ” الرئيس السوري أحمد الشرع على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية. أشار البيان ذاته إلى أنّ الشرع اكتفى بتأكيد التزام سوريا اتفاق فكّ الاشتباك مع إسرائيل، وهو اتفاق يعود إلى أواخر العام 1974.
لم يرد النظام العلوي، الذي سقط مع فرار بشّار الأسد إلى موسكو في الثامن من كانون الأوّل – ديسمبر 2024، استعادة الجولان يوما. كان الاحتلال الإسرائيلي للجولان منذ العام 1967، ضمانة لبقاء النظام الذي وقع مع هنري كيسينجر وزير الخارجية الأميركي ورقة تفاهمات مع إسرائيل. تتضمن ورقة التفاهمات، التي نقلت “شفهيا” إلى إسرائيل، نقاط الالتقاء التي توصّل إليها كيسينجر مع حافظ الأسد. تشمل النقاط الضمانات الأمنية المطلوبة إسرائيليا وذلك تمهيدا للتوصّل إلى اتفاق لفك الاشتباك في الجولان.
نصت ورقة التفاهمات على أنّ ما تضمنته الورقة، ذات النقاط الست، جزء لا يتجزّأ من اتفاق فكّ الاشتباك المنوي التوصل إليه. تمّ التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بالفعل في أواخر العام 1974.
حملت التفاهمات بين الأسد الأب ووزير الخارجية الأميركي، التي تاريخها 28 أيار – مايو 1974، توقيعي وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية السوري عبدالحليم خدّام. هذا يعني بكل بساطة أنّ العلوي كان يتفاهم مع إسرائيل، فيما السنّي من يوقع على التفاهم… أو يلتقي بالإسرائيليين. لا يمكن للعلوي ارتكاب “فعل خيانة”، أقلّه علنا. “فعل الخيانة” متروك للسنّة من أمثال حكمت الشهابي أو فاروق الشرع اللذين التقيا مسؤولين عسكريين ومدنيين إسرائيليين. تفاوض فاروق الشرع مع إيهود باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وتفاوض حكمت الشهابي مع أمنون شاحاك (رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي) بغية التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى انسحاب إسرائيلي من الجولان. كانت المفاوضات مجرّد مفاوضات من أجل المفاوضات. بقيت في الأساس التفاهمات التي توصل إليها كيسينجر مع حافظ الأسد وهي في أساس اتفاق فكّ الاشتباك السوري – الإسرائيلي الذي يعني قبل كلّ شيء ضمانة إسرائيلية لبقاء النظام العلوي في سوريا في مقابل ضمان هذا النظام للأمن الإسرائيلي في الجولان بموجب عبارات صريحة لا لبس فيها.
تغيّرت اللعبة في سوريا حاليا بعدما دخلت تركيا على الخط بقوة. عاد السنّة إلى حكم سوريا، للمرّة الأولى منذ العام 1966، بعدما رفعت إسرائيل الغطاء الذي كانت توفّره لبشّار الأسد والنظام العلوي. لا شكّ أن اللقاء الذي حصل بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع، برعاية الأمير محمّد بن سلمان ولي العهد السعودي، يشكلّ منعطفا في غاية الأهمّية على الصعيد الإقليمي. يعود ذلك إلى أنّه سبقت اللقاء الذي استضافته الرياض اتصالات سورية ـ إسرائيلية وأخرى بين وفود أميركيّة زارت دمشق حديثا. كان أبرز هذه الوفود وفد من زعماء المنظمات اليهوديّة – الأميركيّة على رأسه جوناتان باس الذي يمتلك شركة نفطية أميركيّة. لم يخف باس، الذي التقى الرئيس السوري الجديد، في أثناء وجوده في دمشق أن المطلوب انضمام سوريا إلى الاتفاقات الإبراهيميّة. وقعت هذه الاتفاقات في العام 2020 وكانت بين دولة الإمارات العربيّة المتحدة والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. أدت إلى تطبيع كامل للعلاقات الإماراتية – الإسرائيلية والبحرينية – الإسرائيلية. في وقت لاحق حصل أيضا تطوير للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهي علاقة من نوع خاص في ضوء وجود جالية يهودية مغربيّة كبيرة في إسرائيل. لا يزال يهود المغرب الذين انتقلوا إلى إسرائيل يمتلكون علاقة خاصة ببلدهم الأصلي، بما في ذلك الولاء للعرش المغربي كمؤسسة لم تفرّق يوما بين مواطن مغربي وآخر.
في استطاعة أحمد الشرع، الذي يتمتع حاليا بشعبية كبيرة بين السوريين في ضوء الدور الذي لعبه وليّ العهد السعودي في جعل ترامب يتخذ قرارا برفع العقوبات، الذهاب بعيدا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. يعود ذلك إلى عوامل عدّة من بينها أنّه زعيم سنّي سوري استطاع هزيمة النظام العلوي المرفوض كلّيا من أكثرية السوريين. الأكيد أن الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات مع الإسرائيليين ستلعب دورا مهمّا في تحديد توجّه الرئيس السوري. يساعد في ذلك أيضا أنّ تركيا تعرف قبل غيرها أن دورها في مجال استفادة شركاتها من إعادة إعمار سوريا رهن برضا إدارة ترامب وما تريده هذه الإدارة التي لم تتردد في دعوة سوريا إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيميّة إضافة إلى تقديم طلبات أخرى.
يشبه وضع الرئيس السوري الجديد وضع أنور السادات الذي قرّر في العام 1977 إلقاء خطابه في الكنيست الإسرائيلي تمهيدا لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين في آذار – مارس 1979. كان السادات يتمتع وقتذاك بشعبية كبيرة في ضوء خوض حرب تشرين أو حرب أكتوبر، أمّا مصر فكانت تعاني في تلك المرحلة من أزمة اقتصادية عميقة الجذور. بين امتلاك الشعبية الكبيرة في ظلّ أزمة اقتصادية عميقة ورفض السنّة في سوريا فكرة عودة العلويين إلى حكم البلد، توجد مبررات كافية لذهاب أحمد الشرع إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي تبدو إدارة ترامب مصرّة عليها.
استخدم بشّار وحافظ الأسد الضمانات التي قدماها لإسرائيل من أجل المحافظة على النظام العلوي طوال ما يزيد عن نصف قرن. هل يستخدم السنّي أحمد الشرع التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، بموجب الشروط الأميركيّة الواضحة كلّ الوضوح، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا… وبناء نظام جديد وتثبيت حكمه سنوات طويلة أخرى؟
إعلامي لبناني
العرب
——————————
ترمب وجائزة نوبل للسلام.. هل سوريا هي المفتاح؟/ أحمد زكريا
2025.05.18
تعدّ جائزة نوبل للسلام واحدة من أرفع الجوائز العالمية، تحمل في طياتها رمزية استثنائية تجمع بين الطموح الإنساني والإنجاز الملموس. منذ تأسيسها عام 1901 على يد ألفريد نوبل في السويد، أصبحت هذه الجائزة حلمًا يراود العلماء والسياسيين والناشطين، من نيلسون مانديلا إلى العالم المصري أحمد زويل.
في خضم هذا السياق، يبرز اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشخصية مثيرة للجدل تسعى بقوة لنيل هذا اللقب المرموق، مدفوعًا بطموحه لترك بصمة تاريخية تخلّد اسمه، لكن هل يمكن أن يحقق ترامب هذا الهدف؟ وما الدور الذي قد تلعبه سوريا في هذا المسعى؟
يُعرف ترمب بشخصيته الجريئة وتصريحاته الواثقة، وقد أعرب مرارًا عن رغبته في نيل جائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن إنجازاته تفوق ما حققه سلفه باراك أوباما، الذي نال الجائزة عام 2009.
يرى ترمب أن جهوده في إنهاء النزاعات وتعزيز السلام تستحق التقدير، بل إنه يعتبر نفسه مصلحًا لما أفسده آخرون، وهذا الطموح لا ينبع فقط من رغبة شخصية، بل يعكس استراتيجية سياسية تهدف إلى تعزيز مكانته كرجل دولة يسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي.
خلال ولايته الأولى، ركز ترمب على دبلوماسية الصفقات، حيث أسهم في رعاية اتفاقيات أبراهام التي جمعت إسرائيل بدول عربية مثل الإمارات والبحرين.
هذه الاتفاقيات، التي وُصفت بأنها خطوة تاريخية نحو التطبيع في الشرق الأوسط، أُبرزت كدليل على قدرته على تحقيق السلام. ومع عودته إلى البيت الأبيض في 2025، يبدو أن ترمب يضع نصب عينيه توسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولًا أخرى، وربما تكون سوريا إحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار.
في الآونة الأخيرة، أثارت تصريحات وتحركات ترمب حول سوريا تساؤلات حول دورها المحتمل في مساعيه لتحقيق السلام، خاصة وأن سوريا، التي عانت من حرب مدمرة لأكثر من عقد، تمثل تحديًا معقدًا لأي مبادرة دبلوماسية، ومع ذلك، يبدو أن ترمب يرى فيها فرصة لتحقيق إنجاز دبلوماسي كبير.
هناك تلميحات إلى إمكانية عقد اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، أو ربما دمج سوريا في إطار اتفاقيات أبراهام، كما أشار البعض إلى أن ترمب قد يسعى لتطوير معاهدة فك الاشتباك بين البلدين التي أُبرمت عام 1974 برعاية هنري كيسنجر.
إحدى الخطوات الملفتة التي اتخذها ترمب مؤخرًا هي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا، فالبعض يرى أن هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إنساني، بل جزءًا من صفقة مشروطة تهدف إلى دفع سوريا نحو التطبيع مع إسرائيل.
هذه الخطوة، إذا نجحت، قد تعزز صورة ترمب كصانع سلام، خاصة إذا أدت إلى استقرار المنطقة وتقليص التوترات الإقليمية.
ومع ذلك، فإن هذا المسار ليس خاليًا من العقبات، فالعلاقات بين سوريا وإسرائيل ظلت متوترة لعقود، مع قضايا شائكة مثل هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأي اتفاق سلام محتمل سيحتاج إلى معالجة هذه القضايا، إلى جانب ضمانات أمنية ودعم دولي، علاوة على ذلك، فإن الإدارة السورية، بقيادة أحمد الشرع، قد يواجه ضغوطًا داخلية وإقليمية تحول من دون قبوله باتفاقيات تُنظر إليها على أنها تنازل عن الحقوق الوطنية.
لنيل جائزة نوبل للسلام، يتطلب الأمر إنجازات ملموسة ومستدامة، وليس مجرد نوايا طيبة أو صفقات سياسية.
لجنة نوبل النرويجية معروفة بمعاييرها الصارمة، حيث تمنح الجائزة لمن يسهمون بشكل مباشر في “تعزيز السلام العالمي”، في حين أن ترمب، الذي يروّج لنفسه كرجل صفقات، يواجه تحديات جمة في إثبات أن جهوده تتجاوز المصالح السياسية أو الاقتصادية الضيقة.
على سبيل المثال، اتفاقيات أبراهام، رغم أهميتها، لم تحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وهو العقبة الأكبر أمام السلام الشامل في الشرق الأوسط، كما أن محاولاته لإنهاء الحرب في غزة أو التوترات بين إسرائيل وإيران لم تُكلل بالنجاح الكامل حتى الآن.
وفي سوريا، فإن أي اتفاق مع إسرائيل قد يُنظر إليه على أنه انتصار دبلوماسي لترامب، لكنه قد يثير انتقادات حادة إذا اعتُبر تنازلًا عن مصالح الشعب السوري.
من ناحية أخرى، يتمتع ترمب بدعم قوي من أوساط معينة، خاصة في الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يُنظر إليه كقائد غير تقليدي قادر على اتخاذ قرارات جريئة.
تصريحات مستشاريه ومقربيه تشير إلى أنه يضع نصب عينيه إنهاء الصراعات الكبرى، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، كوسيلة لتعزيز فرصه في نيل الجائزة، لكن هناك أصوات تشكك في نواياه، معتبرة أن سعيه لنوبل قد يكون مدفوعًا برغبة شخصية أكثر من كونه التزامًا حقيقيًا بالسلام.
إذا أراد ترمب تحقيق هذا الحلم، فعليه مواجهة عدة تحديات:
أولًا، يجب أن تكون أي اتفاقية سلام مستدامة وشاملة، تشمل أطرافًا رئيسية مثل الفلسطينيين، الذين ظلوا خارج إطار اتفاقيات أبراهام.
ثانيًا، يحتاج إلى كسب تأييد المجتمع الدولي، بما في ذلك دول أوروبا والصين، التي قد تنظر بحذر إلى تحركاته الدبلوماسية. ثالثًا، يجب أن يتعامل بحذر مع التوازنات الإقليمية، خاصة مع إيران، التي تمثل لاعبًا رئيسيًا في سوريا والمنطقة.
في المقابل، فإن الفرص متاحة أمام ترمب، إذ إن سوريا، بظروفها الحالية، قد تكون أرضية خصبة لتحقيق اختراق دبلوماسي، خاصة إذا تمكن من إقناع الإدارة السورية بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام أو تطوير معاهدة سلام جديدة، ونجاحه في هذا المجال قد يعزز صورته كرجل سلام، لكنه يتطلب مهارة دبلوماسية استثنائية وتنازلات من جميع الأطراف.
سوريا ليست مجرد ساحة نزاع، بل قد تكون العامل الحاسم في طموح ترامب لنيل جائزة نوبل، فقراراته الأخيرة، مثل رفع العقوبات، تشير إلى أنه يراهن على دمشق كمحور لتحقيق اختراق دبلوماسي غير مسبوق.
لكن ما الذي يجعل سوريا مفتاحاً محتملاً وطريقاً بوصول ترمب إلى جائزة نوبل؟
أولاً، استقرار سوريا قد يغير ديناميكيات الشرق الأوسط، خاصة مع تراجع النفوذ الإيراني بعد ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في سوريا.
ثانيًا، إشراك سوريا في اتفاقيات أبراهام قد يفتح الباب أمام دول أخرى مترددة، مثل لبنان أو العراق، للانضمام إلى مسار التطبيع.
ثالثًا، نجاح ترمب في إقناع سوريا بتسوية مع إسرائيل، خاصة بشأن الجولان، قد يُنظر إليه كإنجاز تاريخي يتجاوز ما حققه أي رئيس أميركي سابق، لكن هذا المسار يتطلب تنازلات كبيرة، سواء من سوريا التي قد تخشى ردود فعل شعبية، أو من إسرائيل التي قد ترفض التفاوض حول الجولان.
وإذا نجح ترمب في تجاوز هذه العقبات، فقد يصبح اسمه مرادفًا للسلام في المنطقة، لكن الفشل قد يعزز الانتقادات التي تصفه بالانتهازية.
في النهاية، يبقى السؤال: هل سيحصل ترمب على جائزة نوبل للسلام؟ الإجابة تعتمد على قدرته على تحقيق إنجازات ملموسة ومستدامة، وليس فقط على طموحه الشخصي.
سوريا قد تكون مفتاحًا لهذا الهدف، لكن التحديات السياسية والإقليمية تجعل هذا المسار محفوفًا بالمخاطر.
وإذا نجح ترمب في تحقيق سلام حقيقي يشمل سوريا وإسرائيل، فقد يقترب خطوة كبيرة نحو تحقيق حلمه، لكن، كما يعلم الجميع، فإن طريق السلام ليس مفروشًا بالورود، وجائزة نوبل تتطلب أكثر من مجرد نوايا طيبة أو صفقات سياسية.
تلفزيون سوريا
—————————
حول رفع العقوبات وما بعدها/ أحمد مظهر سعدو
2025.05.18
تنبع أهمية القرار الأميركي في رفع العقوبات عن كاهل السوريين، في أنها ستكون عتبة مهمة في تاريخ سوريا الحديث، تأتي إبان كنس الاستبداد الأسدي، وحالة التغيير الكبرى التي حصلت في سوريا، ويبدو أن إزاحة العقوبات من فوق صدر السوريين، سوف تؤسس لما بعدها، ومن الممكن أن تكون بداية جديدة، ومساحة مهمة متجددة، قد تعادل ماحصل في صبيحة 8 كانون أول/ ديسمبر 2024، من حيث أنها ستفتح الباب على مصراعيه نحو نهضة اقتصادية، وحالة تنموية سورية متميزة طالما حلم بها الشعب السوري، وعمل من أجلها بكل مايستطيع، بعد أن أوصل نظام الفاشيست الأسدي الوضع السوري، والدولة السورية، إلى ما يمكن أن ينطبق عليه بشكل واضح حالة الدولة الفاشلة. ولقد كان أمام الحكومة الانتقالية السورية التي تم تشكيلها بعد الحكومة الأولى المؤقتة، الكثير من المهام والتحديات الصعبة، ليس أقلها الاجابة المباشرة على سؤال يقول: هل من الممكن أن تنهض الحكومة السورية الانتقالية بالاقتصاد المتهالك والخدمات المعدومة، وإعادة لملمة الصفوف السورية، وبناء السور العالي للدولة السورية الطامحة، في ظل وجود عقوبات كثيرة، ليس من ذنب للسوريين أنها موجودة، بقدر ما يتحمل ذلك (بكل تأكيد) نظام الاستبداد المخلوع كل تبعاتها وأسبابها، ومن ثم فإنه من العبث الحقيقي واللاعقلانية في السياسة أن تستمر هذه العقوبات بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث كانت تعيق واقعيًا (بعد سقوط النظام المخلوع) أي عمل نهضوي اقتصادي أو خدمي، أو حتى سياسي، يمكن أن تعمل عليه حكومة الرئيس أحمد الشرع.
والآن وقد زالت هذه العقوبات نظريًا (على الأقل) لمدة 180 يوم حسب التصريحات الأميركية الأخيرة، حيث تحتاج إلى مزيد من الوقت، لتكون ضمن سياقات التنفيذ الفعلي المؤسساتي الأميركي المباشر، قبل أن تمر بما سبق ومرت به قوانين العقوبات أثناء فرضها، من مثل قانون قيصر وسواه، اعتبارًا من أدراج البيت الأبيض والرئاسة الأميركية تحركًا نحو بيروقراطية الكونغرس، ومن ثم وصولًا إلى آليات عمل وتصويت وموافقة مجلس الشيوخ، وبعدها إلى التطبيق العملياتي ثم النفاذ الممارس، وهو الذي سيأخذ بعض الوقت ومع ذلك سوف ينتظره السوريون حكومة وشعبًا، لماله من ضرورات وأهمية، ترتبط به وبها جملة القرارات الحكومية والتحركات الواقعية السورية على طريق بناء الدولة السورية وتحسين الخدمات، وإعادة الاعتبار كليًا أو جزئيًا إلى الليرة السورية، حيث بدأنا نلمس تجلياته في السوق السورية، تلك الليرة السورية كانت قد التي هوت إلى الحضيض، في ظل وجود نظام العصابات الأسدية، والفساد والإفساد كسياسة ممنهجة اتبعها آل الأسد لأنهم كانوا يعتبرون الوطن السوري بمثابة مزرعة مملوكة لآل الأسد وآل مخلوف وتوابعهما.
لعل مابعد قرار الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) من العاصمة السعودية الرياض، برفع العقوبات، هناك المزيد من جولات التفاوض والتحركات على جوانب عملية رفع العقوبات، ليس مع الأميركان في تركيا فحسب، بل لا يمكن أن يكون ما يجري من مفاوضات (غير مباشرة) بين الحكومة السورية الجديدة وإسرائيل، بعيدًا (أو بالتساوق) مع الشروط الأميركية لرفع العقوبات، لأن (دونالد ترامب) يهمه جدًا مايسميه دائمًا بالأمن القومي الإسرائيلي، كما يهمه أيضًا، وضمن عقلية التاجر الأميركي، أن تكون كل الصفقات هذه مرتبطة ببعضها وتؤدي إلى مزيد الفائدة المالية والسياسية، وتساهم في إنجاز وإنفاذ سياسات أميركية في المنطقة العربية والعالم يمكن للرئيس الأميركي (دونالد ترامب) أن يقبض ومعه إدارته الأميركية الكثير من الأموال على طريقها ولصالح الخزينة الأميركية.
وقد يكون الطريق إلى إنفاذ رفع العقوبات قد أضحى سالكًا وسريعًا كما يبدو عبر وبعد العرض السوري الحكومي بمنح معظم استثمارات عملية إعادة الإعمار في سوريا إلى أهم الشركات الأميركية المستوطنة في دول الشرق الأوسط، على حساب السوريين أو الشركات الاستثمارية العربية الخليحية أو الإقليمية.
إذًا من الممكن أن يكون ما بعد رفع العقوبات عن سوريا ليس أقل صعوبة مما قبله، ومن الممكن أيضًا أن يتابع (العم سام) إرسال المزيد من الطلبات والشروط الأميركية وكذلك الإسرائيلية بالضرورة، كي تستمر مسيرة وإجراءات رفع العقوبات سارية المفعول، ومتحركة إجرائيًا دون معوقات قانونية أو سياسية.
إن مابعد رفع العقوبات الأميركية الكثير من المتطلبات الأميركية، والعديد من انبثاقات المصالح الأميركية، التي لابد من تنفيذها من قبل الحكومة السورية، لتكون مدخلًا جديًا لذلك وحتى تكون عملية الانتقال السوري من العقوبات إلى حالة صفر عقوبات، ماثلة وناجزة في ساحة الفعل والممارسة. ويعلم كل متابع لمسارات السياسة الأميركية في العالم، وكان آخرها زيارات الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) لبعض دول الخليج ( السعودية، وقطر ، والإمارات) وكيف أن ترامب وإدارته، بل وكل الإدارات الأميركية المتعاقبة، ما زالت تمسك العصا من المنتصف، و تلوح بالعقوبات والحسم إن لم يكن هناك من فوائد تعود بالضرورة على الخزينة الأميركية، حيث يشارك مع ترامب وزير الخزانة الأميركية كل جولاته في المنطقة العربية والعالم أيضًا.
من الصحيح القول: إن فرحة السوريين لايمكن أن تعادلها فرحة، شعبيًا وحكوميًا، بعد قرار رفع العقوبات الأميركية من فوق كاهل وصدر السوريين، وإن التفاؤل كان وما زال متوفرًا وحيًا، إلا أن (ما بعد السكرة تأتي الفكرة ) كما يقال ، أوالعكس، وهي مسألة لابد من تحمل نتاىجها، حيث يأمل السوريون أن لا تكون النتاىج سلبية على الواقع السوري، وأن تكون هناك أقل الخسائر وليس أكثرها.
ويبدو أن ذلك سوف يبقى مرتبطًا بالضرورة بمستوى أداء الحكومة السورية وجودته، وقدرتها على تحقيق عملية رفع العقوبات، وإنجاز عملية النهوض والتنمية الاقتصادية والخدماتية، بدون أن تعطي للأميركان والإسرائيليين ماتريدانه، ضمن حالة الممكن والمتاح الموضوعية، فمستقبل سوريا المستقرة الموحد والشامخة، هو الأهم، وإعادة عجلة التنمية في سوريا، ضرورة حياتية للناس، بالتساوق مع عملية إعادة الإعمار.
تلفزيون سوريا
———————————
عن إعادة تموقع سورية في الإقليم/ رانيا مصطفى
19 مايو 2025
قرَّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، قبل لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، استجابةً لمطلب ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، وجهود كلٍّ من تركيا وقطر والإمارات وبريطانيا، وبدعم فرنسي كبير. ورغم التباس موقف الكونغرس الأميركي تجاه هذا الشأن بسبب سوء معالجة الحكومة ملفَّي الساحل والجنوب السوري، وبسبب الخلفية الجهادية للحكّام الجُدد، إلا أن عودة ترامب من الخليج العربي إلى البيت الأبيض منتصراً ومحمّلاً باتفاقات بمئات مليارات الدولارات كفيلة بتمرير استثناءٍ أوَّلي يسمح بجذب الاستثمارات إلى سورية وإعادة عجلة الاقتصاد، وصولاً إلى رفع معظم العقوبات.
فرضت واشنطن العقوبات على سورية، وأبرزها قانون قيصر، لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائمه ضدّ السوريين، وأرادت بها منع روسيا وإيران من الاستفادة من سياستهما الداعمة نظام الأسد. ورغم دورها في إنهاء تلك الحقبة، لم تكن تلك العقوبات منصفةً بحقّ السوريين، فليس من المنطق أن تُعاقِب نظاماً على جرائمه بفرض عقوباتٍ على مؤسّسات الدولة أدّت إلى تجويع الشعب، فيما استمرّ الأسد ومقرّبوه بجني الأرباح غير المشروعة. وجاء قرار ترامب اليوم ضمن صفقة تجارية وأمنية أميركية خليجية تعطي دوراً رائداً للسعودية في إعادة تشكيل المنطقة بعد إنهاء النفوذ الإيراني، وإعطاء أدوارٍ متوازنة لكلٍّ من تركيا والسعودية، إذ يلعب موقع سورية الاستراتيجي أهميةً كبيرةً في هذه الخريطة. وسورية اليوم منهكة ومقسّمة، وسلطة الرئيس أحمد الشرع ضعيفة وغير مسيطرة، ومثقلة داخلياً بإرثها السلفي الجهادي، ومنذ وصوله إلى دمشق، تردَّد على لسان الشرع وباقي المسؤولين أن سورية لن تكون منصَّة تهديد لدول الجوار.
لافت أنه بعكس زيارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى المنطقة في النصف الثاني من عام 2022، لم يزر ترامب، رجل الصفقات الكبرى، تلّ أبيب، ما يعكس حجم الخلاف بينه وبين بنيامين نتنياهو، ورغبته في إحداث توازن عربي تركي في مواجهة طموحات حكومة الأخير في المزيد من التهديدات لأمن المنطقة، من دون التردّد في منح الكيان الإسرائيلي كلّ الدعم في مشروعه لتدمير غزّة و”تطهيرها” من حركة حماس، على حدّ تعبير وزير ماليّته بتسلئيل سموتريتش، الذي ربط أيضاً بين أمن إسرائيل وتقسيم سورية. وباستثناء غزّة، التي يريدها ترامب “منطقةً حرّةً”، حسب قوله، وغياب التوافق العربي في إيقاف الحرب فيها، فإن الرجل يسعى إلى إيقاف الحروب كلّها، والقيام برحلات فارهة لإجراء صفقات ضخمة. على ذلك، استطاع كلٌّ من الرئيس التركي أردوغان ووولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقناعه بالمراهنة على إعطاء كل الدَّعم للشرع لتحقيق المصالح الأميركية في سورية، التي تتلاقى مع مصالح الدول العربية، ومنها الأردن وقطر والإمارات، حول إنهاء ملفّ النفوذ الإيراني، وتجارة الكبتاغون، وضبط الحدود، واستقرار سورية، وتدفّق الاستثمارات.
في سنوات حكم الأسد الأخيرة، كانت هناك مبادرات عربية تسعى إلى إعادة سورية إلى الحضن العربي، وإبعادها عن إيران، ومحاربة تجارة المخدّرات، ووافقت واشنطن على تلك الخطوة بانتظار خطوة مقابلة من الأسد، الذي فشل وكان على وشك الانهيار. وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قد انضم إلى قطار إعادة العلاقات مع الأسد، لأسباب داخلية تتعلّق بعودة اللاجئين إلى سورية، الأمر الذي رفضه الأسد تعجرفاً وسوء تقدير. بعد سقوط الأخير، باتت الفرصة مؤاتيةً لتلك العودة السورية إلى الحضن العربي، بوجود سلطة وليدة تحاول ترتيب بيتها الداخلي، وقد أحسنت العمل بالإسراع إلى فتح علاقات مع دول الخليج ودول الجوار العربية، وهنا تأتي الخطوة الأميركية برفع العقوبات عن سورية دفعةً إلى الأمام، لتمكين السوريين من تحقيق الاستقرار الداخلي، وتحقيق المطالب الأميركية.
جاءت تلك المطالب على لسان المتحدِّثة باسم البيت البيض كارولين ليفينت خلال زيارة ترامب إلى الرياض، وتتقاطع مع الشروط الأميركية السابقة، خاصّة ما يتعلق بطرد المقاتلين الأجانب، والمساعدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ومعالجة مراكز الاعتقال التي تخصّ التنظيم، وقد أضيف إليها ترحيل الفصائل الفلسطينية التي وُصفت بالإرهابية، ودعوة دمشق إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. يبدو أن المطلب الأخير جزء مهم من ترتيب إعادة التموضع السوري الجديد، إذ أجاب الشرعُ ترامبَ بـ”نعم” (بحسب الأخير) من دون أن يذكر الحقوق السورية باستعادة الجولان المحتلّ وفق القرارات الأممية، وقد رُفع العلم السوري الجديد فوق تلك الأراضي تعبيراً عن رغبة السوريين هناك باستعادته. ولم يأتِ الشرع على ذكر التجاوزات الإسرائيلية أخيراً باحتلال مناطق في العمق السوري تتجاوز خطّ فكّ الاشتباك لعام 1974، والضربات الإسرائيلية التي دمَّرت كلّ مقدرات الجيش السوري، وهدّدت الرئيس في قصره.
هناك من يرى أن درجة إنهاك السوريين تمنع حكومتهم حتى من العمل الدبلوماسي، وتقديم الشكوى في المحافل الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا استنتاج خاطئ، لا يدرك خطورة الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية بحجّة تولّي تنظيم ذي ماضٍ جهادي الحكمَ. ودولة الاحتلال أرادت ألّا تفوّت فرصة الضعف السوري لإثبات تفوّقها العسكري على دول الجوار، ولمنع بناء قدراتها العسكرية، ولاحتلال المناطق العازلة عملاً استباقياً لأيّ تهديد جديد، ولمنع ظهور نظام سوري قوي، إضافة إلى الحدّ من تهديد النفوذ التركي المتصاعد، وهذا يعني أن دولة الاحتلال تتعامل بوصفها دولةَ “بلطجةٍ” في المنطقة، بمباركة أميركية وأوروبية. في كلّ الأحوال، من المبكر القول إن سورية ستنضمّ إلى الاتفاقات الإبراهيمية، فالسلطة غير مكتملة، وما زالت في المرحلة الانتقالية، إلا أن الموافقة المبدئية من الحكومة السورية من دون استعادة الحقوق والاعتراف بتلك الانتهاكات والتَّعويض عنها ليست الخيار الإجباري للشرع.
الاستناد إلى الشرعية الداخلية سيقوّي أوراق الشرع لتشكيل موقف عربي ضاغط يندّد بالانتهاكات الإسرائيلية في سورية، ويقوّي قدرة الدولة على الاستفادة من تلك الفرص التاريخية كلّها التي تُعطى للسوريين. هذا يعني أنه من الحصافة حسن التصرف، وإعادة النظر في كلّ السياسات التي اتَّبعها الشرع، وتوسيع المشاركة السياسية، وبناء دولة المواطنة للسوريين كلّهم، بدلاً من توجيه سهام التخوين إلى الطوائف والأعراق، وقد ردّد السوريون المحتفلون برفع العقوبات في مختلف المحافظات السورية شعارات تندّد بالطائفية تعبيراً عن رغبتهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة يسودها الاستقرار. ومن الجدير ذكره أن تجارب دول مماثلة لم تنجح في النهوض بالوضع المعيشي والخدمي لمواطنيها بسبب تفشّي الفساد وتغييب دور الدولة. والتصريحات الحكومية كلّها تقول باقتصاد السوق الحرّ شعاراً للمرحلة، من دون تحديد الهدف من تلك السياسات الاقتصادية، هل هي تنموية تخدم طبقات اجتماعية متوسّطة ودنيا، هي في أشدّ الحاجة إلى تحسين أوضاعها، وبناء منازلها المهدّمة، وهذا يستدعي قدراً كبيراً من تدخّل الدولة؟ أم هو اقتصاد حرّ منفلت يخدم طبقة أوليغارشية احتكارية جديدة وحسب، وفاسدة بالضرورة، في ظلّ غياب تشريعات تضمن حرية العمل النقابي والحزبي؟
العربي الجديد
——————————
بغداد والشرع وظلُّ ترمب/ غسان شربل
19 مايو 2025 م
لبغداد قدرةٌ غيرُ عادية على دفع الزائرِ إلى فتح دفاتر الماضي وأوجاعه. تتضاعف القدرةُ حين يختار الأصدقاء أن يكونَ العشاء على ضفة دجلةَ ثم تكتشف لدى وصولك أن المنتجعَ الحالي حلّ ضيفاً على ما كان واحداً من قصور حقبة صدام حسين.
لازمني شعورٌ بأنَّ الناسَ كما العهود والأفكار ركاب في قطار الوقت يعبرون كما تعبر مياه النهر محكومة بالاختناق عند المصب. والفارق بين العابرين هو الوجهة التي يسافر إليها والبصمات التي يتركها. حراس الماضي يسافرون إليه ويغرقون فيه. ورجال المستقبل يكافحون لإزالة الركام والنجاة من زنزانات الخوف أو القوالب. هذا الحديث طويل. لنترك الماضي يمضي وننتقل إلى الحاضر.
احتضنت بغدادُ القمة الرابعةَ والثلاثين لجامعة الدول العربية وكأنَّها ترغب في إيفاد رسائل عدة. أولى الرسائل أنَّ بغداد مستقرة وآمنة وقادرة على احتضان حدث بهذا الحجم من دون تدابير أمنية منهكة لبعض المدينة وبعض سكانها. والثانية أنَّ بغداد تدرك أهمية العمل العربي المشترك وفرص تفعيله وأنَّها صاحبة مصلحة في تسارع وتائر رحلة القطار العربي في التعاون والتبادل والتشاور. والرسالة الثالثة أنَّ بغداد ملتزمة ما اصطلح على تسميته الثوابتَ العربية سواء في ما يتعلق بحل الدولتين أو البحث عن حلول عبر التفاوض لتضميد جروح الخرائط العربية المتصدعة.
يعرف الصحافيون بحكم التجربة أنَّ المناقشات التي تدور على هامش القمة لا تقل أهمية أحياناً عن الكلام الذي يقال داخلها، خصوصاً أنَّ أروقة المؤتمر والفنادق تحرر المتحدثين من القيود الرسمية.
كان باستطاعة الصحافي الزائر أن يلاحظَ أن موضوعين هيمنَا على مناخات القمة وما حولها انطلاقاً من الاعتقاد أنَّهما سيتركان بصماتها على التطورات في المرحلة المقبلة. التطور الأول يتعلَّق بسوريا بعد مصافحة دونالد ترمب وأحمد الشرع في الرياض وقرار الإدارة الأميركية الحالية رفع العقوبات عن سوريا تلبية لطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لاحظ كثيرون أنَّ الشرع «حصل على جرعة استثنائية من الدعم العربي والدولي، ما يُبقي دول الجوار أمام خيار وحيد هو التطبيع مع سوريا الشرع والتعاون معها».
راودتني رغبة في معرفة صورة الشرع لدى عدد من الذين التقوه من بلدان عدة. ورجعت من الأسئلة بالآتي:
– الشرع رجل براغماتي يدرك جيداً على أي أرض يقف ويدرك تعقيدات الجغرافيا السورية وذيول علاقاتها الصعبة مع جيرانها.
– يحاول تبديد أي شكوك حول إمكان أن يغرف من تجاربه السابقة لانتهاج سياسة متشددة. ثمة من سمعه يردد علانية وفي اللقاءات المقفلة أنَّ سوريا لن تكون مصدر قلق لأي من جيرانها. واستنتج الزوار أنَّ إسرائيل مشمولة بهذا الكلام.
– ثمة من سمعه يقول إنَّ مواجهة إسرائيل بالطرق التقليدية قادت إلى الكوارث التي نراها. الخيار الوحيد أمام سوريا هو أن تصون وحدتها واستقرارها وتبني اقتصادها وتسترجع المهجرين ثم تستثمر علاقاتها العربية والدولية للضغط الدبلوماسي على إسرائيل. وهذا يعني ببساطة الخروج من النزاع العسكري مع إسرائيل، وهذا ليس بسيطاً بالنسبة إلى من يمسك بمفاتيح دمشق.
– لمس الزائرون أنَّ إيران و«حزب الله» يتصدران لائحة خصوم الشرع، في حين يعتبر أن بقاء القواعد الروسية يتوافق ومصلحة سوريا.
– يتفق كثيرون على أنَّ التحدي الأكبر أمام وفاء الشرع بالوعود التي قطعها للإدارة الأميركية هو طبيعة القوى التي عملت معه إلى موعد إطاحة نظام بشار الأسد ولكونه يشير إلى نهاية زمن الفصائل.
– لاحظ مشاركون أنَّ الدور الذي لعبه الأمير محمد بن سلمان في إحداث تحول سريع في موقف ترمب من الشرع هو إشارة إلى ازدياد الثقل السعودي لدى واشنطن، فضلاً عن احتفاظ الرياض بعلاقات ممتازة مع الصين وروسيا وأوروبا.
– توقع مشاركون أن يلعب الثقل السعودي دوراً كبيراً في إطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة.
تطور آخر يعني العراق ودول المنطقة، وهو ظلّ ترمب الذي خيّم على المنطقة بعد زيارته الخليجية الأخيرة ومحطتها الاستثنائية في الرياض.
قال عدد من المشاركين إنَّ زيارة ترمب طوت صفحة الحديث القديم عن أن أميركا تعبت من الشرق الأوسط وتريد الاستقالة من أي مسؤولية تجاه مستقبله. أعادت زيارة ترمب التأكيد على أنَّ الحديث عن عالم متعدد الأقطاب لا يزال مبكراً، ذلك أنَّ الأرجحية لا تزال محسومة للهالة الأميركية في العسكرية والاقتصاد، وأنَّ المعبر الأميركي إلزامي لمن يبحث عن حلول للأزمات المستعصية، من غزة إلى النووي الإيراني.
ويلمحون إلى أنَّ ظلّ ترمب أرخى بثقله على الملفات الشائكة من أوكرانيا إلى غزة ومعها النووي الإيراني. وتسمع في بغداد أنَّ التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران مرجح لأنَّ عواقب الانزلاق إلى مواجهة ستكون باهظة التكاليف للمنطقة وللاقتصاد العالمي وستضع العراق في وضع شديد الصعوبة.
وهناك من يعتقد أنَّ طهران تدرك بلا شك أنَّ ملامح جزء من المنطقة قد تغيرت، وتحديداً في الجزء الذي نشط فيه الجنرال قاسم سليماني واستثمر فيه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. ويلمح هؤلاء إلى أنَّ إيران بدأت في حلقات ضيقة عملية مراجعة لتجربة العقود السابقة لأنَّ ما يجري يتناول أمنها وحجم دورها وحضورها في الإقليم.
ولا ينكر بعض المشاركين أنَّ إسرائيل خرجت من حروب ما بعد «طوفان الأقصى» وهي «أقوى بكثير مما كانت عليه قبله»، وأنَّ ترمب «هو الوحيد القادر على ضبط سلوكها العدواني أو تخفيفه».
تقرأ بغداد في تجربة الشرع وتحاول استكشاف توجهات ظل ترمب خصوصاً على إيران وخياراتها. انشغال بغداد بهذه الملفات لا يلهيها عن الانغماس قريباً في مناخات الانتخابات النيابية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي الطريق إلى الانتخابات سؤال عن ظل مقتدى الصدر على الانتخابات إن شارك فيها وبوادر معركة قاسية داخل «الإطار التنسيقي» وتطلع نوري المالكي إلى حرمان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الفوز بولاية جديدة.
الشرق الأوسط
———————————-
سورية من إرث الاستبداد إلى بناء الدولة الجديدة/ فيصل يوسف
19 مايو 2025
في ظلّ سنوات طويلة من الصراع والدمار، ومعاناة يومية أثقلت كاهل السوريين، يبرز قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بصيصَ أمل في نفق طويل من الظلمة، لما يحمله من دلالاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قد تُفضي إلى بداية مسار جديد نحو انفراج تدريجي للأزمة، وتوفير أرضية أكثر ملاءمةً لعملية سياسية شاملة ومستدامة، تعالج ما خلّفه النظام البائد من دمار ومعاناة وشرخ عميق في بنية المجتمع والدولة.
تكشف نظرة فاحصة إلى التجربة السابقة أن الإجراءات الاقتصادية، التي غالباً ما يجري تقديمها في سياق “الأدوات غير العسكرية”، قد أثبتت محدوديةَ فعّاليتها في تحقيق الأهداف المُعلَنة، بل إنها، في الواقع، لامست بشكلٍ مباشر حياة المواطنين السوريين، وأثّرت في قدرتهم على تأمين ضرورات الحياة الأساسية. لقد تحوّلت هذه الإجراءات، في أحيانٍ كثيرة، إلى عوامل مساعدة في تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي، وتفسير قصور الخدمات العامّة، وتفاقم مشكلة الفقر والنزوح على نطاق واسع. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار القرار الأميركي المعلن أخيراً بمثابة قراءة جديدة للواقع، نحو تبنّي استراتيجيات أكثر واقعية وتركيزاً في البعد الإنساني، وتشجّع على تفاعل بنّاء وتدريجي مع أيّ سلطة تنفيذية تلتزم مساراً انتقالياً حقيقياً.
إن الآثار الإيجابية المحتملة لتخفيف العقوبات تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، لتشمل إمكانية إيجاد مناخ أكثر إيجابية لتعزيز الثقة وفتح قنوات للحوار. ومع ذلك، يظلّ تحقيق هذه الإمكانات مرهوناً بمدى قدرة المؤسّسات السورية، حكوميةً ومجتمعيةً، على إدارة الموارد بشفافية وعدالة، وضمان وصولها إلى مستحقّيها بعيداً من مظاهر الفساد والاستئثار. كما يستلزم ذلك تضافر الجهود بين الأطراف المحلّية والإقليمية والدولية لدعم الاستقرار الشامل وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، التي تمسّ حياة المواطنين بشكل ملموس.
وعلى صعيد السياق السياسي الأوسع، يكتسب تخفيف العقوبات دلالاتٍ إضافيةً، إذ يتزامن مع حراك دبلوماسي إقليمي ودولي متزايد بشأن مستقبل سورية. يمكن النظر إلى هذه الخطوة حافزاً غير مباشر إلى دفع العملية السياسية، وفقاً لجوهر قرار مجلس الأمن 2254، الذي يشدّد على أهمية بناء نظام حكم ديمقراطي تعدّدي يضمن كل حقوق السوريين، وتنوّعهم، ويضع حدّاً لممارسات الاستبداد والإقصاء التي عانتها البلاد عقوداً.
تفرض المرحلة المقبلة مسؤوليةً مضاعفةً على عاتق الحكومة السورية، والقوى الوطنية الفاعلة كافّة، تستدعي التعامل مع هذه اللحظة المفصلية بروح من الجدّية والمسؤولية الوطنية. يتطلّب ذلك ترجمةَ النيات الحسنة خطواتٍ عمليةً ملموسةً على صعيد إطلاق إصلاحات هيكلية حقيقية في منظومة الحكم، وإظهار التزام راسخ بسيادة القانون ومكافحة الفساد بأشكاله كلّها، وتوسيع فضاء الحرّيات العامّة، وضمان مشاركة سياسية فاعلة لكل ألوان الطيف السوري. لم تعد تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مجرّد مسألة خدماتية، بل أصبحت مكوّناً أساسياً في عملية استعادة الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وخطوةً ضروريةً نحو تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
في صميم أيّ تصوّر لمستقبل سورية، تبرز القضية الكردية اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة والمجتمع على استيعاب التنوّع وتحقيق العدالة، فالشعب الكردي، الذي يمتلك جذوراً عميقةً في هذه الأرض، وإسهامات تاريخية في بنائها، ظلّ يعاني سياسات التهميش وإنكار الهُويَّة والحقوق المشروعة عقوداً. لا يمكن أيّ مشروع وطني شامل ومستدام أن يكتمل من دون معالجة هذه القضية بشكل عادل وجذري، من خلال تضمين الحقوق الثقافية والسياسية للكرد في الدستور السوري، وضمان مشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، بما يعكس انتماءهم الوطني الأصيل وشراكتهم الكاملة في بناء سورية الغد.
إننا نرى اليوم ملامح إجماع وطني متزايد حول الرؤية المستقبلية لسورية، دولةً مدنيةً ديمقراطيةً لا مركزيةً، تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والمساءلة، وتقوم على شراكة وطنية حقيقية ومتكافئة بين جميع مكوّناتها. وفي هذا الإطار، فإن أبناء سورية يتطلّعون، إلى مبادرات بنّاءة من الأشقاء والأصدقاء، تسهم في تعزيز هذا التوجّه، عبر تمكين الشعب السوري من بناء دولته الجديدة على أسس راسخة من الوحدة الوطنية، والتنوّع، الثقافي والقومي والديني.
تكتسب الجهود المبذولة لتوحيد الموقف الكردي وتشكيل وفد موحّد أهمية قصوى، ليس ضرورة لتمثيل مصالح المكوّن الكردي فقط، بل إسهامٌ حيوي في تعزيز الوحدة الوطنية، لأن وجود صوتٍ كرديٍّ موحّد في أيّ حوارات سياسية مقبلة يُعزّز من قوة هذا المكون وقدرته على الدفاع عن حقوقه المشروعة، ويمثّل، في الوقت نفسه، إضافةً نوعيةً إلى الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء نظام ديمقراطي تعدّدي، يضمن المواطنة المتساوية، ويؤسّس لحكم رشيد يشارك فيه الجميع في صنع القرار وتحديد المصير المشترك.
تأكيد وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية قاسم مشترك يجمع عليه جميع السوريين، إلا أن هذا المفهوم لا ينبغي أن يُختزَل في إطار المركزية الصارمة، التي أثبتت التجارب أنها كانت بيئةً حاضنةً للفساد والتهميش والإقصاء. يمثّل تبنّي نظام ديمقراطي لا مركزي ضمانةً حقيقيةً لتوزيع عادل للسلطة والموارد، وتمكين المجتمعات المحلّية من إدارة شؤونها بكفاءة وفعّالية ضمن إطار الوحدة الوطنية، بما يُعزّز الانتماء الوطني، ويُحقّق التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد. تصوير هذا الخيار دعوةً إلى التقسيم ينبع من فهم ضيّق لطبيعة الدولة الحديثة، التي تستمدّ قوّتها من قدرتها على احتواء تنوّعها، وتقدير اختلافات مكوّناتها، وبناء شرعيتها على أساس من رضا مواطنيها وثقتهم بمؤسّساتها.
ختاماً، يتطلّب استثمار هذه اللحظة التي تحمل في طياتها بوادر انفتاح سياسي واقتصادي تبنّي رؤية وطنية متكاملة وشاملة لبناء سورية المستقبل. رؤية تنطلق من الاعتراف بالحقائق الراهنة، وتؤمن بالشراكة السياسية والاجتماعية الحقيقية، وتتبنّى إصلاحاتٍ جوهريةً تمسّ جوهر المشكلات، وتضع المواطن السوري، بكلّ مكوناته وتطلعاته، في صلب أيّ مشروع وطني. لقد آن الأوان لتجاوز حقبة الاستبداد والانقسام، والانطلاق نحو بناء عقد اجتماعي جديد، يفتح الباب أمام مستقبل تزدهر فيه سورية بتنوعها ووحدة أبنائها.
العربي الجديد
——————————
رفع العقوبات عن سوريا والتنسيق الأمني على طاولة البحث بين واشنطن وأنقرة
تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن، يوم غد الثلاثاء، مجموعة العمل التركية ـ الأميركية بشأن سوريا.
ووفقاً لما كشفته مصادر وكالة «الأناضول» في وزارة الخارجية التركية، اليوم، سيُعقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأميريكي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة آلية رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، إلى جانب الجدول الزمني والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص. كما من المنتظر أن يؤكد يلماز خلال الاجتماع، أهمية التنسيق متعدد الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، من أجل ضمان الأمن والاستقرار في سوريا عبر الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
كذلك، من المتوقع أن يتناول الاجتماع أولويات كل من تركيا والولايات المتحدة في سياساتهما تجاه سوريا، بالإضافة إلى «بحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا»، وفقاً لـ«الأناضول». وسيكون ملف مكافحة «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى من أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أيضاً.
كذلك، يُنتظر أن يتم خلال الاجتماع تقييم فرص التعاون بشأن المعسكرات الموجودة شمال شرق سوريا، إلى جانب تقديم واشنطن معلومات عن العملية الجارية لإعادة تنظيم وجود قواتها العسكرية في هذا البلد، بحسب الوكالة نفسها.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة نظراً لانعقاده بعد لقاء مباشر بين الرئيسين السوري والأميركي (في السعودية)، وإعلان دونالد ترامب نيته رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
——————————-
“الديون البغيضة” في القانون الدولي: هل تنجو سوريا من فواتير الأسد؟
2025.05.19
أثار الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا بعد لقاء الرئيس دونالد ترمب مع نظيره السوري الجديد أحمد الشرع، تساؤلات قانونية حول مصير الديون التي راكمها نظام بشار الأسد خلال سنوات الحرب، وتطرح هذه التساؤلات في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة دمج اقتصادها المنهك في النظام المالي العالمي.
تحمّل النظام المخلوع ديوناً ضخمة، خصوصاً من إيران وروسيا، لتمويل عملياته العسكرية منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، وتواجه الحكومة الجديدة، التي يقودها أحمد الشرع بعد الإطاحة بالأسد، خياراً قانونياً وسياسياً حساساً: هل تلتزم بهذه الديون، أم تحاول التنصل منها باعتبارها “ديون حرب” أو حتى “ديون بغيضة”؟.
وفقاً لمبدأ “الخلافة الحكومية” في القانون الدولي، يُفترض أن ترث الحكومات الجديدة التزامات أسلافها، بغض النظر عن الاختلافات السياسية، لكن فقهاء القانون ناقشوا منذ أكثر من قرن استثناءً نادراً لهذا المبدأ، هو “الديون البغيضة”، التي تُعد غير ملزمة إذا استُخدمت لقمع الشعب أو لم تحقق أي نفع له.
تصنيف “ديون الحرب”
يرى كاتبا المقال، سي بوشايت وميتو جولاتي، في مقالهما الذي حمل عنوان: (ماذا سيحدث لديون الحرب السورية؟
)، لـ”رويترز”، أن هذا الاستثناء يصعب تطبيقه قانونياً، إلا أن فئة “ديون الحرب” قد تمثل مخرجاً للحكومة الجديدة، وتستند هذه الحجة إلى أمثلة تاريخية، كرفض بريطانيا دفع ديون حكومة جنوب إفريقيا بعد حرب البوير، ورفض كمبوديا سداد ديون حرب حكومة لون نول، ما يدل على إمكانية التنصل من ديون تم اقتراضها لتمويل القتال ضد ثورة انتهت بانتصار المتمردين.
لكن الوضع السوري يطرح تحديات إضافية، فهناك تساؤلات حول ما إذا كانت الالتزامات المالية التي أبرمت قبل اندلاع القتال واستُخدمت لاحقاً في الحرب، تندرج تحت هذا الاستثناء، كما أن الجانب السياسي والدبلوماسي للديون، خاصة مع موسكو وطهران، يعقّد أي محاولة للتنصل منها من دون تداعيات.
يبقى ملف الديون السوري معقداً، وقد تحتاج الحكومة الجديدة إلى مفاوضات دقيقة أو دعم قانوني دولي للتمييز بين الديون المشروعة وتلك التي استخدمت لقمع السوريين.
—————————–
واشنطن تنهي العزلة الاقتصادية لدمشق بعد إعلان ترامب رفع العقوبات
19 مايو 2025
في مشهد دراماتيكي قلب موازين السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع جميع العقوبات عن دمشق واضعًا حدًا لعقود من العزلة، ومطلقًا وعودًا ببداية اقتصادية جديدة، بحسب تقرير لصحيفة “ذا أوبزيرفر” البريطانية.
وتشير “ذا أوبزيرفر” في مقدمة تقريرها إلى أنه بعد أن قضى الرئيس السوري، أحمد الشرع، عقدًا من الزمن مُلاحَقًا بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار لقيادته جماعة جهادية، في إشارة إلى “هيئة تحرير الشام”، صافح مبتسمًا رئيس الدولة التي احتجزته في سجن أبو غريب سيئ السمعة في العراق.
وأعادت الصحيفة التذكير بالتصريحات التي أطلقها ترامب، واصفًا الشرع بأنه “شاب جذاب لديه فرصة حقيقية للنجاح”، مشيرةً إلى أن لقاء ترامب المفاجئ بالشرع في الرياض، خلال جولته في الشرق الأوسط، لم يكن يقتصر على الرمزية السياسية الثقيلة، بل أعقبه “إعلان مذهل”، وفق تعبير الصحيفة.
وكان ترامب قد قال مخاطبًا قادة دول الخليج: “سنرفع كل العقوبات عن سوريا لنعطيهم فرصة لبداية جديدة”، وأضاف أن العقوبات الأميركية التي امتدت لعقود “كانت مدمرة حقًا وقوية جدًا”. وبحسب “ذا أوبزيرفر”، فإن هذا الإعلان كان له وقع كبير في الشارع السوري، إذ خرج الآلاف للاحتفال في الساحات من دمشق إلى حمص وإدلب، رافعين الأعلام السورية إلى جانب الأعلام السعودية.
وقال الخبير المالي السوري كرم شعار في رسالة مصوّرة لـ”ذا أوبزيرفر”، بينما كانت أبواق السيارات تدوي في شوارع دمشق: “أنا في غاية السعادة لرؤية هذا يحدث”، وأضاف: “نحن السوريون نستحق بداية جديدة”.
ووفقًا لـ”ذا أوبزيرفر”، عانى السوريون لسنوات تحت حكم سلطوي صارم من الانقطاع عن النظام المالي العالمي، وحتى من خدمات البريد الإلكتروني الأميركية، بسبب العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي المقابل، فيما كانت عائلة الأسد تعيش في قصور فارهة، وترتدي أزياء لمصممين عالميين وتتنقل بسيارات فاخرة، كان المواطن العادي مهددًا بالسجن إذا خرق قوانين مشددة تمنع التعامل بالعملات الأجنبية.
وكانت السلع المستوردة تُخبّأ بعيدًا عن الأنظار، بينما يتداول الناس أسعار الدولار بكلمات مشفرة مثل “ربطة بقدونس” أو “نعناع”، في إشارة إلى السوق السوداء، بحسب التقرير ذاته.
ورأت “ذا أوبزيرفر” في تقريرها أن قرار ترامب انقلب على سنوات من السياسة الأميركية التي أبقت على العقوبات الشاملة، حتى بعد فرار الكثير من رموز النظام السابق إلى موسكو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لافتةً إلى ذهاب ترامب إلى أبعد من تخفيف العقوبات، داعيًا إلى رفعها بالكامل.
وقبل أسبوع من زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، التقت مجموعة العمل الطارئة السورية بالشرع ومسؤولين آخرين في الحكومة الجديدة، حيثُ عملوا على إقناع ترامب برؤية فرصة اقتصادية في سوريا التي تعيد بناء نفسها.
واقترحوا خلال الاجتماع أن تتخلص شركات الاتصالات الأميركية سريعًا من منافسيها الصينيين، ونقلت “ذا أوبزيرفر” عن رجل أعمال أميركي قوله مازحًا إن بإمكان أحدهم بناء “برج ترامب” في دمشق.
وقال مسؤول حكومي أميركي لم يُكشف عن اسمه: “ما أعلنه الرئيس كان مفاجئًا للجميع”، وأضاف أن إعلان رفع العقوبات بشكل كامل “فاق التوقعات بكثير”، مشيرًا إلى أن ترامب “تبنى أقصى موقف ممكن في رفع العقوبات”.
وأضاف أن البيت الأبيض كان يشهد منذ أشهر صراعًا داخليًا حادًا بين بيروقراطيين واقعيين أرادوا رفع العقوبات بعد سقوط الأسد، وبين فريق يقوده مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، المعروف بتشدده ومخاوفه من ماضي الشرع الجهادي.
ولفتت “ذا أوبزيرفر” إلى أن فريق غوركا هو من صاغ لائحة “الشروط السامة” التي قُدمت لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بروكسل، بهدف إجهاض أي محاولة لرفع العقوبات عبر وضع شروط يصعب تحقيقها.
ونقلت “ذا أوبزيرفر” عن المسؤول الحكومي قوله إن “ترامب وحده من امتلك الجرأة والصلاحية للمضي في رفع العقوبات بالكامل”، مشيرًا إلى أن “المعركة الحقيقية الآن هي حول مدى وسرعة تنفيذ القرار”، لافتًا إلى أنه “بدون أمر مباشر من الرئيس، سيتحول التنفيذ إلى مراحل بطيئة ومعقدة”.
وأضاف التقرير أنه كما جرت عادته في السياسة الخارجية، قلب ترامب قواعد اللعبة بكلمات جريئة، لكن التنفيذ يبقى رهن التفسيرات والتجاذبات، موضحًا أنه لا يزال الغموض في واشنطن سيد الموقف حول ما يمكن أن يحدث لاحقًا.
ونوه التقرير إلى طلب موظفي الخارجية من وزارة الخزانة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد السوري ومنع انهيار المصرف المركزي بعد سقوط الأسد، لكن الخطة بقيت مجمّدة بسبب العقوبات. ومع ذلك أصبح الآن يمكن نظريًا تنفيذها، بشرط الانتصار في المعركة البيروقراطية.
ووصفت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، ديلاني سيمون، قرار ترامب بأنه: “خطوة تاريخية بكل المقاييس”، مضيفة أنه “أمر شبه غير مسبوق في تاريخ تخفيف العقوبات”. لكنها حذّرت من أن رفع العقوبات “عملية معقدة بطبيعتها”، وتتطلب موافقة وكالات متعددة، بالإضافة إلى الكونغرس.
ويُشير أنصار رفع العقوبات إلى “قانون قيصر”، الذي وقّعه ترامب بنفسه عام 2019 لمعاقبة الأسد على جرائم حرب، باعتباره يُعطل جهود إعادة الإعمار، ويجب التصويت على إلغائه سريعًا، وفقًا لـ”ذا أوبزيرفر”.
وقال مدير المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن سياسة الرئيس “تحتاج إلى الدفاع عنها من خصومها داخل إدارته”، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الذي أعدت المنظمة بفعله وثيقة أطلقت عليها مسمى “قرار تنفيذي تجريبي”.
وتقترح الوثيقة، بحسب “ذا أوبزيرفر”، رفع التجميد عن ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على الأعمال التجارية، والتي تشمل بندًا يمنح ترخيصًا عامًا يُشرع كل المعاملات التي كانت محظورة سابقًا، بما فيها “استيراد وتصدير السلع والخدمات والتكنولوجيا، والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات”.
وأشار مصطفى إلى أن العقوبات التي تطلب الوثيقة رفعها هي “من الوثائق التي يحب ترامب توقيعها، وتمنحه الفرصة لتجاوز من يريدون إبطاء رفع العقوبات”.
ورغم الفرح في دمشق، يرى خبراء مثل كرم شعار أن الكثير من الأسئلة لا تزال مفتوحة. إذ على الرغم من إعجاب ترامب بالشرع، ما زال الأخير وعدد من وزرائه خاضعين لعقوبات مكافحة الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة.
واختتمت “ذا أوبزيرفر” تقريرها بالإشارة إلى قول شعار الذي أكد أن “هناك ما يستحق الاحتفال، لكن علينا ألا نستبق الأحداث”، مضيفًا “السؤال الكبير الآن هو: هل ستدفع واشنطن مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء تلك العقوبات؟”.
——————————–
=====================