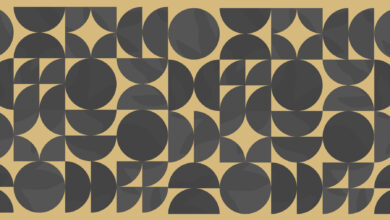عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 23 ايار 2025

لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
————————————-
=
الفصائل المسلحة في السويداء بين صراع الوطنية ورهانات السلاح/ مهيب الرفاعي
الجمعة 2025/05/23
لعب الدروز دوراً مهماً في بناء الدولة السورية، لكنهم تعرضوا للتهميش بعد انقلاب عام 1963 وما تبعه من تصفيات داخلية، خاصة مع رفضهم الانخراط في الخط البعثي، وارتباطهم بدروز لبنان المعارضين لتدخل الأسد. وقد زادت القطيعة مع النظام بعد اغتيال قيادات درزية بارزة ككمال جنبلاط، ما أدى إلى استبعادهم من مراكز القرار في الحزب والجيش والأمن، باستثناءات نادرة مثل عصام وأسامة زهر الدين، الضابطين في المخابرات العسكرية.
هذا التهميش عمّق شعورهم بالغبن، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في محافظة السويداء. وعام 2022، انطلقت احتجاجات سلمية في السويداء عبّرت عن رفض الفساد وغياب الدولة، ورفعت شعارات الثورة السورية، مطالبة بتنفيذ القرار 2254، والكشف عن مصير المعتقلين، وخروج القوات الروسية والإيرانية. ورغم تشويه نظام الأسد لهذا الحراك والحملة الإعلامية ضده، تميز الحراك بطابعه المدني، وشارك فيه شباب ونساء وزعامات دينية، مع تنسيق واضح مع درعا؛ وحاول نظام الأسد احتواءه دون استخدام العنف المفرط، عبر ضغوط واتصالات محلية؛ في الوقت الذي ظهرت فصائل محلية مثل “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” لحماية المجتمع والحراك من الأمن والفوضى، ورفض أي تطرف أو تبعية.
نحو مشروع وطني جامع
بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، سعت الإدارة الجديدة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة في السويداء مع وجود رغبة وإرادة سياسية حقيقية، تُعيد للدروز مكانتهم التاريخية، وتُحقق تطلعاتهم في العدالة والمساواة واحترام تنوع البلاد، والاستفادة من إرثهم النضالي ومثقفيهم. ومنذ الأسابيع الأولى، دعت الإدارة الجديدة إلى دمج الفصائل المحلية في مؤسسات الدولة من خلال برامج تأهيل وتدريب لضمان ولائها، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار؛ كما دعت إلى تعزيز دور القضاء المحلي وتفعيل الضابطة العدلية بإشراف شخصيات موثوقة من أبناء المحافظة لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتوازى مع إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف المعنية.
شهد المشهد العسكري في السويداء بعدها تنوعاً لافتاً في الفصائل المسلحة من حيث التكوين والانتماء والرؤى السياسية والأمنية، وهو تنوع ناتج عن التحولات الداخلية والإقليمية، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية بشأن “حماية الدروز”. ويمكن تصنيف هذه الفصائل إلى تيارين رئيسيين: الأول هو الفصائل التقليدية ذات التوجه المعتدل، مثل “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” و”تجمع أحرار الجبل”، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المرجعيات الدينية التقليدية وتؤدي دوراً محلياً في حماية أمن الجبل دون انخراط في مشاريع انفصالية أو فيدرالية، مع إبقاء مسافة محسوبة من السلطة الجديدة التي تقبل بها بشروط تحفظ استقلالية القرار المحلي.
أما التيار الثاني فيتمثل في الفصائل الراديكالية حديثة التشكيل، مثل “قوات العليا” و”سرايا الجبل” و”شيخ الكرامة”، والتي تتبنى مواقف الشيخ حكمت الهجري وتطرح مشاريع سياسية أكثر طموحاً، تدعو إلى نظام فيدرالي وترفض السلطة الجديدة بشكل قاطع، كما تسعى إلى توحيد العمل العسكري ضمن هيكل مؤسساتي يحقق التمثيل السياسي لمحافظة السويداء.
فصيل ثالث
ورغم التباينات الجوهرية بين هذين التيارين، فإن كليهما يتفق على أولوية الدفاع عن السويداء ورفض أي تهديد خارجي، خصوصاً من الجماعات المتطرفة أو التدخلات الإقليمية. وفي موازاة ذلك، يبرز فصيل ثالث مغاير من حيث الهوية والانتماء، يتمثل في “تجمع عشائر السنة” من البدو وعشائر السنة المقيمين في السويداء، وهو داعم صريح للسلطة الجديدة ويتميّز بقربه منها مقارنة بالفصائل الدرزية. ويعكس هذا التعدد الفصائلي توتراً عميقاً بين الهوية الوطنية والخصوصية الطائفية، وبين المركزية واللامركزية، ويكشف عن مشهد غير متجانس تتحكم فيه المرجعيات الدينية والانتماءات السياسية والمواقف من القضايا الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها العلاقة مع إسرائيل والإدارة الذاتية.
التوترات الأمنية وشبح العسكرة
ومع تصاعد التوترات الأمنية في السويداء، وتعدد الفصائل والولاءات، واتساع دائرة المزايدات بالوطنية والانتماء، ودخول العشائر على الخط عبر مناوشات مع فصائل محلية في المدينة والقرى المحيطة، كان لا بد من إفساح المجال لرجال الدين والمسؤولين الأمنيين المحليين ليكونوا مرجعيات معنوية وعملية في أوقات حرجة، لا سيما وأن الحكومة السورية الجديدة تركز على محافظة السويداء لترتيب أوراقها وتصحيح مسار التعامل معها عمّا كان عليه نظام الأسد، مع تقديم ضمانات حقيقية عبر الممثل الحكومي (المحافظ) فيها، من خلال اجتماعاته مع الوجهاء ورجال الدين.
ويبرز دور المشيخة في ضبط السلم الأهلي عبر تهدئة التوترات الداخلية، ودرء الاقتتال بين الفصائل المحلية المعارضة للحكومة الجديدة والموالية لها. كما كانت طرفاً مقبولاً لدى الأهالي للتفاوض مع الدولة الجديدة من خلال منع الانزلاق نحو الحرب الأهلية داخل السويداء ودعم الاحتجاجات السلمية والوقوف بوجه العصابات والفلتان الأمني الذي حصل في الأسابيع الأولى من التحرير ولو عبر وساطات معنوي وأهلية. ولم تكن مشيخة العقل داعمة لحمل السلاح خارج الدولة بشكل دائم، لكنها في الوقت نفسه تفهمت الأسباب التي دفعت الفصائل للتسلح، مثل غياب الأمن وعمليات الخطف وتفشي الجريمة. لذا كانت دعوات المشيخة دائماً تدور حول حصر السلاح بيد الدولة، لكن بعد إصلاح أجهزتها وتفكيك العصابات الإجرامية المرتبطة ببعض المليشيات المحلية التي لربما يكون لها ارتباطات خارجية مع التأكيد على إعادة بناء ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.
تعزز هذه التوصيات موقع المشيخة الدينية في عملية السلم الأهلي وخلق مناخ آمن لتفعيل دور العدالة الانتقالية، كونها تؤكد على ترسيخ موقع المشيخة كمؤسسة وطنية لا طائفية، تعبر عن الدروز كمكون وطني، لا ككيان منفصل؛ مع إشراك المشيخة في جهود المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي.
تغيرات تجاه الفصائل المسلحة
من خلال البيان الصادر عقب اجتماع المشايخ مع محافظ السويداء، يبدو أنهم قد حسموا موقفهم بوضوح تجاه مسألة السلاح والفصائل المسلحة التي أصبحت تشكل تهديداً واضحاً لسيادة الدولة وممثليها في المحافظة، لا سيما بعد الاعتداءات المتكررة من قبل أفراد ومليشيات منفلتة على مبنى الأمن الجنائي ومبنى المحافظة وصولاً إلى الاعتداء على مكتب المحافظ شخصياً. فقد أبدوا قلقاً واضحاً من حالة الفوضى التي نجمت عن تجاوزات بعض الأفراد بحق الضابطة العدلية وعناصر الشرطة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ خطوة لافتة بتفويض الفصائل المحلية والأهلية بدعم مهام هذه المؤسسات، لا بهدف فرض واقع مليشياتي، بل في محاولة لضبط السلاح وتوجيهه نحو حماية القانون وهيبة الدولة.
ومن خلال دعوة المشيخة العلنية لجميع الفصائل بالتعاون الكامل مع الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية، هناك نية جدية لتحويل الفصائل من قوى خارجة عن القانون إلى شركاء في حفظه، ضمن أطر واضحة تحترم المؤسسات القضائية والشرطية. والأهم من ذلك، أن المشيخة لم تكتفِ بالدعوة، بل أطلقت تحذيراً واضحاً من أي اعتداء على هذه الأجهزة أو على أفرادها، في خطوة تُظهر تحولاً نوعياً في الخطاب والموقف تجاه منطق الفوضى والسلاح المنفلت.
في المقابل، يظهر أن المشيخة لا تتعامل مع الفصائل وحدها، بل توجه أيضاً خطاباً مباشراً لعناصر الشرطة من أبناء المحافظة، تدعوهم فيه لاستعادة دورهم على الأرض بفعالية وجدية، رغم المقومات اللوجستية الضعيفة، لا سيما وأنهم يدركون أن أي نجاح في فرض القانون لا يمكن أن يتحقق دون عودة المؤسسات الرسمية للقيام بمهامها، وهو ما يجعل موقف المشيخة أقرب إلى رسم معادلة جديدة قائمة على فكرة أن السلاح يجب أن يُضبط، والفصائل يجب أن تتحول من أدوات نزاع إلى أدوات دعم، والقانون هو المرجعية الأولى للجميع.
يعكس هذا الطرح توجهاً جديداً يسعى إلى كبح العشوائية وتنظيم دور القوى الأهلية ضمن مظلة القانون، بما يشير إلى وعي متزايد بأن الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا بتكامل الأدوار بين المجتمع المحلي ومؤسساته الرسمية.
دفع هذا التغير حركة “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” إلى إعادة الانتشار في المحافظة، تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون ووضع حد للسلاح المنفلت الذي يهدد السلم الأهلي في السويداء.
المدن
——————————
الطائفية والاستراتيجية الإسرائيلية.. تفكيك سوريا/ عبد الله مكسور
2025.05.22
عندما ينكفئ النظام الدولي عن قيمه، ويُسلم زمام القيادة لمنطق الغلبة لا العدالة، تبدأ خارطة العالم بالاهتزاز على وقع هويات ضيقة، وتُصبح الطائفية والانتماءات الضيقة أداة لإعادة رسم الجغرافيا وحدود الاشتباك.
فالهوية حين تُختزل إلى ذاكرة جريحة، تصبح سلاحاً في يد من يعرف كيف يوظفها. في الحالة السورية، لم تعد إسرائيل مضطرة لإظهار أنيابها في اجتياحات تقليدية، فحضورها لم يعد عسكرياً ثابتاً ومباشراً، بل ناعماً، مراوغاً، متسللاً عبر التشققات الطائفية، ومن خلال فراغ الدولة التي تحاول تدريجياً استعادة المشروع الجامع والتمثيل الوطني. وفي مثل هذا السياق المتداعي، لا تعود الطائفية مجرّد انحراف اجتماعي أو أثر جانبي لتاريخ من الانقسامات أو الأزمات أو حتى الحرب الأهلية.
بيع الوهم الإسرائيلي
لم تعد تل أبيب بحاجة إلى أن تُقنع العالم “بمخاوفها” من جبهة جنوبية نشطة سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، بل يكفيها أن ترى “الوطن السوري” يتحول إلى فسيفساء مفككة، تتصارع فيها الكيانات على سلطة محلية خالية من الجوهر الوطني، وتنهض فيها الطوائف كملاذ للخوف لا كمكون منسجم ضمن كيان واحد. مدركةً تماماً أنه عندما يُفقد الإحساس بالانتماء الأوسع، يصبح صوت الجماعة الصغيرة أقرب إلى صراخ النجاة وطلب النجدة، بهذا الصراخ تتغذى الاستراتيجيات الإسرائيلية، فيُصاغ التدخل لا على هيئة صاروخ أو طائرة، بل على هيئة رعاية للمخاوف، ودعم للمظلوميات، ووعود بالحماية. وهكذا تُستثمر الطائفية لا بوصفها حتمية تاريخية، بل باعتبارها موردًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، يُعاد إنتاجه إسرائيلياً بلا كلل. فكلما تصادمت الطوائف، تقدّمت إسرائيل خطوة إضافية في مشروعها.
في الحالة السورية، تتجلى هذه المعادلة بوضوح حاد. إذ لم تعد إسرائيل، وهي أحد أبرز المستفيدين من هذا التفتت الإقليمي، في حاجة إلى حروب شاملة أو اجتياحات برية كما فعلت في بيروت عام 1982. بل تدخل من نوافذ الهوية المذعورة في لحظة تاريخية مضطربة بالنسبة لسوريا. تدرك تل أبيب، أن البيئة الأمنية التي تتيح لها لعب دور “الحامي من الخوف” هي أكثر نجاعة من أي احتلال عسكري قد ينهار أمام مقاومة أو متغير دولي. لذلك تسعى لخلق ظروف تجعل من التدخل المستدام ضرورة محلية قبل أن يكون قراراً خارجياً. إنها تفعل ذلك باسم “الحماية”، بينما جوهره يقوم على هندسة التفكيك الناعم، الذي يُبقيها حاضرة في الجغرافيا دون أن تظهر في الخرائط الرسمية. فنكون جميعاً في خريطة دولة تتفكك إلى كيانات رخوة، تتوزعها الولاءات المذهبية والمناطقية، وتفتقر إلى أي مشروع وطني جامع أو سردية وطنية قابلة للتوحيد. إسرائيل تدرك أن الدول لا تسقط فقط عبر الحرب، بل قد تسقط عبر “الهندسة الهادئة للهويات”، وهي تُتقن فنون هذه الهندسة.
إنها اللحظة الإسرائيلية المثالية، التي لا تحتاج فيها إلى الدبابات بل إلى خرائط تُعاد حضورها بهدوء فوق هشيم من الثقة الوطنية المتهالكة. “التفكك المستدام”، ذاك المفهوم الذي تحوّل من تكتيك إلى استراتيجية، هو الغاية التي تتطلع إليها إسرائيل في الحالة السورية: تفكيك الانتماء قبل الحدود، تفتيت الرؤية الجامعة قبل الجغرافيا، وترسيخ منطق الطائفة بوصفها الملاذ الأخير. في ظل هذا المشهد، يحضر تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المولود في الجولان السوري المحتل، كدليل واضح على هذا المنطق حين قال بوقاحة سياسية: “نهاية ما يحدث في سوريا هو أن تصبح دولة مفتّتة، ضعيفة، مجزّأة.” هذا التصريح لا يُقرأ بوصفه موقفاً عابراً، بل يعكس ما يمكن تسميته بالعقيدة الأمنية–الاستراتيجية لدى الدولة العبرية، ومفادة أن إسرائيل إسرائيل إلى القضاء على الدولة السورية، بل إلى إبقائها في حالة “اللا دولة”، لا قوية ولا موحدة، بل كيان مُعلّق بين الوجود والعدم. وفي هذا المسار، يتجلى ما يمكن وضعه في خانة رؤية الأمن القومي الإسرائيلي استراتيجياً: سوريا لا يُفترض أن تعود كيانًا موحدًا، بل يجب أن تبقى “معلّقة” بين الوجود واللاوجود، بين الدولة واللادولة، بحيث تتحوّل إلى حقل رملي من الهويات المنفصلة، يسهل إدارة صراعاتها، ولا يمكن لمخيلتها الوطنية أن تنهض من بين الركام.
تفكيك العصب الوطني
هذا لا يتحقق باجتياح عسكري أو باحتلال مباشر، تدرك إسرائيل أن أقوى أشكال التفتيت ليست تلك التي تحدث عبر الحرب، بل عبر إعادة تشكيل المخيال العام. من خلال سياسة “تفكيك العصب الوطني”. يتم ذلك عبر إعادة تعريف سوريا ليس ككيان سياسي، بل كـ”حيّز طائفي” يتنازع فيه الزعماء المحليون على تمثيل طوائفهم، لا على تمثيل الدولة. وبهذا المعنى، تصبح الجغرافيا قابلة لإعادة التشكيل، لا بالدماء وحدها، بل بالعقول والمخاوف والتمويل. ويُعاد إنتاج الخارطة، ليس وفق السيادة، بل وفق الهوية الضيقة، فتنهار فكرة الكيان الجامع، حتى لو بقيت العاصمة تحت علم الجمهورية. فالجماعة التي تتبنى الطائفية فقدت الثقة في فكرة الوطن، وتحولت ذاكرتها إلى أرشيف للمظلومية، وهذا ما يُنضِج ظروف التقسيم من الداخل. فعندما تنهار الرواية الكبرى، يخرج كل واحد من كهفه شاهراً سيفه أو عصاه دفاعاً عن روايته، هذا هو جوهر اللعبة الإسرائيلية: سحب الغطاء عن الرواية الجامعة، وترك الجميع يتصارعون على الخوف. من هنا تصبح الطوائف ليست فقط أداة للتمايز، بل وحدة هندسية جديدة تُرسم بها خرائط النفوذ. الطائفة، حين تُسلخ عن بعدها الثقافي والديني وتُختزل في سعي بعض أعضائها إلى تحويلها لهوية سياسية مهما كان الثمن، تتحول إلى وحدة قياس تستخدمها قوى الخارج لتحديد مصالحها. وفي هذا المربع تتفوّق إسرائيل على خصومها؛ لأنها لم تعد تحارب بالطائرات بل بالأفكار، لا تبني مستوطنات فقط، بل تبني ذهنيات ملوثة بالخوف والانعزال.
الخوف والانعزال المبني على المظلومية، والذاكرة المجتزأة، والانتماء المغلق كملاذ خوف، فإن هذا التكوين يُصبح منجمًا سياسيًا لا يُهدر. ومن خلاله، تُعاد صياغة القيمة المعيارية للوطن السوري بحيث يصبح خليطًا من الهويات الجزئية، تتحرك كل واحدة منها تحت وطأة التهديد المتخيل والمزعوم من الأخرى، وتبحث عن حماية لا في الدولة، بل في الخارج، حيث تقدّم إسرائيل نفسها، إلى جانب قوى إقليمية أخرى، كضامن “موثوق”. وهنا يتبدى جوهر التحول: لم تعد الطائفة إطارًا ثقافيًا أو دينيًا، بل تحولت إلى “وحدة سياسية قابلة للإدارة”، وإلى عنصر في معادلة إقليمية يُعاد من خلالها تعريف السيادة.
صناعة الطائفية
لا بد أن يدرك السوريون والسوريات أن الخطر لا يكمن في وجود الطوائف، بل في تحوّلها إلى نظام إدارة. كما جاء في أحد الأمثال الإسرائيلية: “حين يتقاتل الجيران، تبني إسرائيل السياج وتفتح بوابة خلفية لكل منهم”. إنها لا تصنع الطائفية من عدم، لكنها ترعاها بصبر سياسي طويل. لا تطلق شرارتها الأولى، لكنها تغذيها بالخوف والتمييز والتضليل. كل طائفة تُقدَّم لها إسرائيل باعتبارها الحامية من الأخرى، والشريك المحتمل، وحتى المُخلص من الفوضى. وهنا، يتداخل الأمني مع الإنساني، والسياسي مع الطائفي. فتُمنح الطوائف مساعدات “إنسانية”، وتُعالج جراحها في مستشفيات مموّلة، وتُدعم فصائلها المسلحة بذكاء ناعم، لا لتحقق نصراً، بل لتتوازن ضمن معادلة هشّة. وتصبح الخرائط الطائفية هي الأرضية الجديدة التي تبني عليها إسرائيل مشروعها في “الهلال الهشّ”، فكلما ازداد الانقسام، ازدادت القدرة على التدخل، ليس فقط جغرافيًا، بل بنيويًا ونفسيًا وثقافيًا.
لقد انتقلت العقيدة الإسرائيلية من منطق الاحتلال الكلاسيكي إلى ما يمكن تسميته بـ”الهيمنة الرمادية”، التي لا تُظهر وجهها القاسي، بل تختبئ خلف واجهات متعددة: حماية الأقليات، ومواجهة إيران، ودعم الاستقرار. وهي بذلك، تقدم خطابًا مزدوجًا: للداخل الإسرائيلي المضطرب، بأنها تحقق أهدافها من دون خسائر بشرية كبرى؛ وللخارج، بأنها شريك استقرار في منطقة مأزومة. لهذا نراها تطرح مشاريع من شاكلة “ممر داوود الاستراتيجي”/” ربط البحر الميت بالبحر الأحمر”. لا كخطط اقتصادية فحسب، بل كتحركات هندسية أمنية تحت غطاء التوازن المائي والجغرافي، وخلق عوازل بالمعنى العسكري قابلة للتوظيف لاحقًا في أي صراع. ويُعاد إحياء مخططات قديمة من أرشيف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تراهن على إدارة منطقة مفككة تقوم على الكانتونات، لا على الدول، وعلى التحالفات الوظيفية لا السيادة.
إنها عودة إلى منطق شمعون بيريز حين قال: “الشرق الأوسط الجديد لا يُبنى بالجيوش، بل بالشبكات”، لكنه هذه المرة يُبنى بشبكات الطوائف، لا شبكات التكنولوجيا. أما الطائفية، فهي هنا ليست انتماءً روحياً أو شعورًا دينيًا، بل منظومة إدارة، ونموذج تقسيم، وآلية لضمان استمرار العجز السياسي. مظلومية تُسندها ذاكرة موجّهة، وخوف متبادل يُكرّس الانفصال الوظيفي بين المكوّنات. وكلما طال هذا الانفصال، تأجلت أي فرصة لبناء مشروع وطني سوري متماسك. فتبدو إسرائيل أقل كقوة احتلال، وأكثر كمحور توازن. وتُعاد صياغة مفهوم “الحماية” ليتحوّل من الدولة إلى الخارج، ومن الجيش إلى “الضامن الإقليمي”. وتُخاض الحروب، لا من أجل توحيد البلاد، بل من أجل ضمان استقرار التفكك.
والنتيجة في كل هذا انهيار الدولة في مضمونها، لا في مؤسساتها الشكلية. أما الأخطر من الانهيار، فهو إعادة تعريف سوريا كحيّز طائفي غير قابل للحكم من الداخل، لكنه قابل للإدارة من الخارج. إنه نوع من الاستعمار الناعم الذي لا يرفع الرايات، بل يعيد ترسيم الوعي. يهمّش الوطنية لصالح المذهبية، ويستعيض عن السيادة بالوكالة، ويحوّل المقاومة إلى أزمة داخلية تُدار بدل أن تُطلق. ولن يكون هناك مشروع سوري جامع ما لم يتم تفكيك الرؤية الطائفية التي تعمل بوصفها ماكينة إعادة إنتاج للهشاشة، ومصنعًا دائمًا للارتهان.
إعادة إنتاج الخرائط
في الخطاب الإسرائيلي تجاه سوريا، يبرز تعبير “حماية الأقليات” ليس كمجرد “شعار إنساني”، بل كأداة استراتيجية متعددة الوظائف، تُستخدم لتغليف التدخل غير المباشر بغلاف أخلاقي زائف، ولإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية تحت عباءة العناية بالضعفاء. هذه الأداة ليست وليدة اليوم، بل تجد جذورها في سردية متكررة، بدأت مبكرًا بعد نكبة فلسطين، حين دفعت إسرائيل المجتمع الدرزي في الداخل المحتل إلى الاندماج القسري ضمن جهازها الأمني والعسكري عبر قانون الخدمة الإلزامية، في محاولة لخلق نموذج أقلية “موالية” تُوظَّف داخليًا لتفتيت الهوية الفلسطينية، وتُصدَّر خارجيًا كدليل على “تعددية الدولة العبرية”. ومع ذلك، قاومت الحركة الوطنية الدرزية هذا المسار لعقود، ورفض كثير منها الانخراط في مشروع يشرعن الاحتلال ويؤبد التمييز. وعادت هذه المعادلة إلى الواجهة حين صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل “ملتزمة “أخلاقيًا” بعدم السماح بحدوث “مجزرة ضد الطائفة الدرزية في سوريا”. لكن المفارقة الأخلاقية هنا فادحة: الدولة ذاتها التي تقونن التمييز ضد مواطنيها العرب، وتقصف المدنيين في غزة، وتُحاصر الفلسطينيين في الضفة، وتعتدي على لبنان وسوريا، تتحدث فجأة بلسان الراعي الإنساني! ما تسعى إسرائيل إليه ليس إنقاذ “طائفة محاصرة”، بل بناء نقطة ارتكاز داخل الخارطة السورية يمكن إعادة تفعيلها لاحقًا كوسيلة ضغط، أو كحزام أمني ناعم لا يتطلب وجوداً عسكرياً مباشراً. إنها سياسة استباقية تهدف إلى حياكة شبكة علاقات داخل سوريا تُمكّن إسرائيل من التحرك بمرونة حين تنضج الظروف. وكما قال تشرشل: ” في السياسة لا توجد صداقات دائمة، بل مصالح دائمة”، يبدو أن تل أبيب تسعى إلى صياغة مصالحها عبر تفكيك البنى الوطنية، لا مواجهتها. وهنا تندرج فكرة “سوريا المفيدة”، التي روّجت لها مراكز التفكير الاستراتيجي الإسرائيلية، باعتبارها الحصيلة المنطقية لتفكك الدولة السورية: طوائف تُحكَم ذاتياً، وكيانات تُغلّف نفسها بدروع مذهبية، وخرائط جديدة تُرسم داخل الخرائط القديمة. وهذا – بطبيعة الحال- لا يُعيد فقط إنتاج نموذج “سايكس–بيكو” بحروف طائفية هذه المرة، بل يجعل إسرائيل شريكاً في صوغ الهوية السياسية للمشرق، لا مجرد متطفل عليها. إسرائيل التي طالما خافت من أن تبقى “حارة يهودية وسط الوطن العربي”، تدفع الآن بكل قواها لجعل المنطقة تشبهها: فسيفساء طائفية وهويات متناحرة، تُدار عبر خطوط تماس لا حدود دولية، وتُبنى حولها علاقات “تبعية وظيفية”، لا شراكة وطنية أوقومية.
تهشيم الجغرافيا الهشة
في هذه البيئة، تبدو الطائفية وكأنها شكل من أشكال الحكم غير المُعلَن، تقوم على مظلوميات متبادلة، ومخاوف مزمنة، وشعور دائم بأن “الآخر” تهديد وجودي. وهنا تستثمر إسرائيل ليس فقط في الانقسام، بل في الحاجة إلى “الحماية”، وتُقدِّم نفسها كـ”قوة توازن” لا كقوة احتلال. وهذا هو أخطر أشكال التدخل: حين يتحول الخصم إلى ضامن، والمحتل إلى شريك، والمشروع التفكيكي إلى سردية خلاص. ومخاطر هذا التسلل الطائفي الإسرائيلي لا تقتصر على الداخل السوري، بل تمتد كأمواج دوّامة إلى الإقليم كله. فالهويات حين تُهشَّم، لا تبقى محصورة داخل الجغرافيا التي تنفجر فيها، بل تُصدِّر ارتجاجاتها إلى المحيط، خاصة في غياب المشروع المضاد. والسؤال المركزي هنا: من يردع إسرائيل؟ ليس فقط بالمعنى العسكري، بل بالمعنى الحضاري والسياسي؟ من يمتلك القدرة على تقديم نموذج دولة يتجاوز المذهب والطائفة والعِرق؟ دولة تُعيد تأسيس المواطن بوصفه كائناً سياسياً لا طائفياً، وتحميه بالعدالة لا بالولاء، وبالمساواة لا بالخوف؟
الفراغ العربي
اليوم، تتحرك إسرائيل في فراغ عربي قاتل، يفتقر إلى المبادرة والرؤية، وتتآكل فيه البنى القومية كما تتآكل الأطراف المتروكة في العاصفة. الأمم المتحدة نفسها، التي كان يُفترض أن تشكل مظلة شرعية، أصبحت عاجزة عن وقف المجازر أو الحد من الأطماع. وفي هذا الفراغ، تُعيد تل أبيب تموضعها، فتُبرر القصف بالحماية، والاختراق بالوساطة، والهيمنة بالاستقرار. وهذا ليس محض تكتيك؛ بل عقيدة متكاملة تقوم على “الهندسة الناعمة للهويات”. الردع الحقيقي لا يكون بالصواريخ وحدها. كما أن الرد على الطائفية لا يكون بطائفية مضادة، بل بتأسيس وطن يتسع للجميع. المشروع البديل هو في استعادة سوريا ككيان سياسي جامع، يحتوي مواطنيه دون استثناء، ويمنحهم شعوراً بالانتماء لا بالخوف. وحدها الدولة التي تتجاوز تقسيمات الولاء واللون الواحد قادرة على إعادة إنتاج معنى “الهوية الجامعة”، وقادرة في الوقت ذاته على إغلاق الباب أمام الطموحات الإسرائيلية، ومنعها من أن تتحول من فرضيات عسكرية إلى هندسة واقعية مستدامة.
فإسرائيل، كما يقول أحد جنرالاتها السابقين، “لا تخشى الخصوم الذين يملكون السلاح، بل أولئك الذين يملكون رؤية”. القوة التي لا ترافقها فكرة، تشبه السيف بلا يد. أما الفكرة التي تستند إلى مشروع وطني صلب، فبوسعها أن تُربك أقوى العقائد الأمنية. وقد قرأنا في الفكر الصهيوني أنَّ ما لا يمكن تحقيقه بالقوة، يمكن تحقيقه بالمزيد من القوة. لكن ما تخشاه إسرائيل اليوم، هو أن تولد في محيطها دولة تقول العكس: “ما لا يمكن الحفاظ عليه بالقوة، لا يستحق أن يُبنى بالقوة”. وفي هذه اللحظة تحديدًا، يكون الصراع ليس على الأرض فقط، بل على المعنى. على هوية المكان، على سرديته، وعلى من يملك الحق في تسميته وطنًا.
وطنٌ تديره دولة سورية جديدة قادرة على تجاوز الانقسام، وتبني مفهوم المواطنة على أساس العدالة لا الحماية. المشروع المضاد للخطوات الإسرائيلية العملية، يبدأ من الداخل. من إعادة تعريف سوريا كدولة لكل مواطنيها، دولة تقطع الطريق على كل مشروع تفتيتي، وتعيد للهوية معناها، وللسيادة كرامتها. وحدها هذه الدولة، بكل ما تتطلبه من شجاعة سياسية وخيال وطني، يمكن أن تُفشل الرهان الإسرائيلي وتُخرج تل أبيب من دور “المنقذ الإقليمي”. وإن لم يُكسر هذا المسار الآن، فإن الخارطة المقبلة للمنطقة برمتها تُرسَمُ في مراكز التفكير الأمني الإسرائيلي، ولن توقفها بيانات الإدانة والشجب والتنديد.
تلفزيون سوريا
—————————–
الدروز في زمن اليقظة/ مكرم رباح
على “الجهّال” أن يقرأوا التحولات بعمق، لا أن يتنافسوا على فرض هوية سياسية مدمِّرة للطائفة
آخر تحديث 20 مايو 2025
“قومٌ بلا جُهّال ضاعت حقوقهم، وقومٌ بلا عُقّال صاروا قَطايع”.
لعل هذه الحكمة تعبّر في جوهرها عن الوضع الراهن في سوريا، إذ تتصاعد المواجهة بين الإدارة الجديدة للرئيس أحمد الشرع، ودروز سوريا الذين ما زالوا يرفضون مركزية السلطة وفرض نزع سلاحهم بالقوة، ودمجهم قسرا ضمن الجيش السوري الجديد.
الجدلية بين “العُقّال” و”الجُهَّال” في السياق الدرزي تتجاوز التقسيم الديني الداخلي، ذلك أن رجال الدين (المشايخ) يُعَدون طبقة “العُقَّال”، أما العامة من غير المتدينين فيُطلق عليهم “الجهّال”، الذين لا يُسمح لهم بالخوض في أسرار العقيدة. لكن في الحالة الراهنة، بات المصطلح يُستخدم بشكلٍ مجازي للدلالة على الانقسام السياسي داخل الطائفة، بين دعاة الحكمة والحفاظ على الوجود، ودعاة المغامرة والانخراط في مشاريع أكبر من طاقتهم.
في هذا السياق، تصبح “اليقظة” ضرورة استراتيجية، لا تعني الاستسلام أو التواري خلف الشعارات الكبرى، بل تعني الاعتراف بحجم الذات السياسي والديموغرافي، مقابل اتخاذ مواقف صلبة– وربما عنيفة إذا لزم الأمر– لضمان الحقوق والكرامات. اليقظة هنا ليست دعوة للعزلة أو الانفصال، بل لفهم موقع الدروز– والسوريين عموما– في خريطة الصراع الإقليمي، والتعامل معهم على أنهم شركاء حقيقيون، لا رعايا تابعون ولا مشاريع مؤقتة.
فاليقظة لا تعني التخندق بل الوعي، ولا تعني الاستسلام بل الكرامة. إنها فنّ الإمساك باللحظة التاريخية وتحديد حجم الدور الممكن تأديته دون التوهم بأن الطائفة قادرة وحدها على تغيير مسارات دولية. كما أنها ترفض خطابا قديما يعيد إنتاج الانقسام بين الانعزالية والمغامرة، وتقدّم بدلا عنه مزيجا من الواقعية السياسية والتجذر المجتمعي.
في سوريا، يشكّل “العُقال”– بالمعنى السياسي– الغالبية داخل الطائفة الدرزية، ويتركز همّهم على البقاء على أرضهم، والتمسّك بكرامتهم، ورفض الانخراط في مشاريع سياسية وحدودية أو تقسيمية قد تجرّهم إلى الهلاك. في المقابل، تبرز فئة من “الجهّال” بالمعنى السياسي، تدعو للانخراط في صراعات إقليمية كسبيل للتموضع، فتارة يؤكدون على “عروبة وإسلامية” الطائفة، وتارة يروّجون للارتهان لمحاور دولية وإقليمية، لا سيما إسرائيل، مستندين إلى روابط الدين والقربى مع دروز إسرائيل.
إن الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا في جرمانا وأشرفية صحنايا، بين مجموعات درزية وقوات تابعة للحكومة الانتقالية وحلفائها من الفصائل الإسلامية، ليست مجرد حدث عارض، بل تعبير جوهري عن فشل الحكم الجديد في تقديم نفسه كممثل لكل السوريين. كما أنها دليل إضافي على إخفاق الحكم في طمأنة الأقليات بأن مصيرها في عهده سيكون مختلفا عن مصير العلويين في الساحل، الذين استُبعدوا من صُنع القرار رغم أنهم لم يكونوا جزءا من الانقلاب.
تكمن خطورة هذا الصراع في كونه يختبر حدود صبر الأقليات، ويطرح تساؤلات وجودية حول معنى الانتماء إلى دولة لا تعترف بخصوصياتهم، بل تطالبهم بالذوبان الكامل في مشاريع عسكرية لم يُستشاروا في صياغتها.
أعاد ردّ النظام بعنف على احتجاجات الدروز، إلى الواجهة حقيقة أن بناء دولة لا يُحققه مرسوم رئاسي أو رفع شعارات تنادي بالوحدة، بل إنه نتاج عقد اجتماعي جديد يحمي التنوّع ويمنح الأقليات ضمانات دستورية. هذا ما فشل النظام الجديد في تقديمه حتى الآن، مما يهدد بتوسيع الشرخ بينه وبين المكونات غير السنّية.
من الضروري في هذا السياق التمييز بين دروز سوريا ودروز لبنان وإسرائيل، على صعيد التركيبة الاجتماعية والسياسية. فجبل الدروز (أو جبل العرب كما يُفضِّل البعض تسميته) كان دائما كيانا مختلطا، لكن النظام البعثي قمع الزعامة الدرزية السياسية لعقود. فسلطان باشا الأطرش، رغم حيثيته كرمز وطني، قضى أيامه الأخيرة في نوع من الإقامة الجبرية في القريا. أما القادة التاريخيون الآخرون مثل شبلي العيسمي (الذي خطفه النظام السوري عام 2011 من لبنان) وسليم حاطوم وفهد الشاعر، فهُم نماذج حول مصير الدروز الذين تحدّوا النظام.
في ظل غياب التمثيل السياسي، تولّت المَشيخة الروحية في السويداء زمام القيادة الرمزية للطائفة، ممثّلة بمشايخ العقل الثلاثة (آل جربوع، آل حناوي، آل الهجري) الذين، رغم تقديرهم، لم يتحوّلوا إلى زعماء سياسيين، ولا يبدو أنهم يطمحون لذلك.
في المقابل، دروز لبنان يدورون بمعظمهم في الفلك السياسي لوليد جنبلاط، الذي تجاوز في العقود الأخيرة الانقسام التقليدي بين آل جنبلاط وآل أرسلان، وأصبح الممثل السياسي الأول للدروز. أما في فلسطين المحتلة، فإن المرجع الروحي هو الشيخ موفق طريف، سليل عائلة دينية بارزة، لكنه لا يدّعي تمثيل الموقف السياسي للدروز في إسرائيل، كما أن علاقته بالدولة العبرية تبقى دينية أكثر منها سياسية.
العلاقة بين دروز الدول الثلاث تتجاوز الحدود والجغرافيا، فالتعليم الديني الدرزي يرسّخ مبدأ “الذود عن الإخوان”، الذي يجعل كل درزي مسؤولا عن الآخر. لكن هذا الرابط لا يعني تبني المواقف السياسية ذاتها. فمشاركة 500 درزي من الجولان في زيارة مقام النبي شعيب مؤخرا لا تعني تطبيعا مع إسرائيل، ويجب عدم تحميلها أكثر من بعدها الروحي والاجتماعي.
من هنا، من الخطأ الرهان على أن حكومة نتنياهو ستتدخل عسكريا لحماية دروز سوريا، إذ إن سجل هذه الحكومة، التي تفاوضت مع “حماس” على حساب رهائنها، يُظهر أنها لا تعبأ كثيرا بالدم اليهودي، فكيف بالدرزي؟ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر للدروز كشركاء مخلصين في جيشها، وتحترمهم لدورهم التاريخي، وقد تقدّم بعض الدعم المحدود كما فعلت في لبنان إبان حرب الجبل، لكنها لن تتحوّل أبدا إلى ذراع تنفيذية بيد مشايخ السويداء.
وحتى هذا الدعم– إن حصل– يبقى محكوما بسقف سياسي تحدده تل أبيب وفق مصالحها، وليس وفق حاجات المجتمع الدرزي أو رغباته. اليقظة الحقيقية هنا تعني التحرر من أوهام الحماية الخارجية، والإدراك بأن مناعة المجتمع تبدأ من داخله لا من حلفائه.
وعند الحديث عن واقع السويداء، تجدر الإشارة إلى أن المحافظة ذات غالبية درزية مطلقة، ومن هنا، فإن إصرار حكومة الشرع على إدخال قوات نظامية، معظمها من رفاق سلاحه السابقين في تنظيماته الجهادية، يشكّل استفزازا خطيرا. والأجدى التوصل إلى تفاهم على صيغة محلية أمنية، تحفظ كرامة أهالي المنطقة، بدلا من فرض السيطرة بالقوة.
على “الجهّال”، من الدروز وغيرهم، أن يقرأوا التحولات بعمق، لا أن يتنافسوا على فرض هوية سياسية مدمِّرة للطائفة. وفي المقابل، على الدروز الذين يطالبون بالحماية الدولية أن يَتَيّقظوا لكون انخراطهم في مواجهة قوات الشرع تزامن مع إعلان تركيا السماح لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها نحو أذربيجان، وهي خطوة صغيرة في الشكل، لكنها عميقة في المضمون. إذ تشير إلى أن التفاهمات الإقليمية تجري فوق رؤوس “القبائل الصغيرة”، وأن التضحيات لا تساوي شيئا أمام مصالح الكبار.
وما لم يدرك الدروز هذا الواقع، فإنهم مهددون بالتحول إلى ورقة تفاوضية في صراعات الآخرين. أما الخيار البديل، فيكمن في بناء سردية سياسية مستقلة تعيد تأطير العلاقة مع المركز، وتؤسس لحوار داخلي يحدد بوضوح ماهية الدور الذي يمكن أن تؤديه الطائفة داخل سوريا الجديدة، دون تهويل أو تبعية.
وختاما، فإن دروز سوريا، شأنهم شأن باقي السوريين، خائفون من مستقبل غامض. تجاربهم مع نظام “البعث”، ومع إدارة الشرع الحالية، لا تبشّر بخير. نزع سلاحهم الثقيل والمتوسط قد يكون خطوة ضرورية، لكن لا يمكن أن يتم دون ضمانات حقيقية بوجود دولة، وليس بوجود جهاز أمني جديد يحمل اسم “الجيش السوري”.
لا يكمن التهديد الحقيقي في وجود الدروز وسلاحهم، بل في استمرار الإنكار الرسمي لحقيقة أن بناء سوريا الجديدة يتطلب شراكة وطنية ودستورية، تضمن للأقليات، ومنهم السنّة، الشعور بأنهم شركاء حقيقيون في بيت سوري متداعٍ، لكنه بيتهم رغم كل شيء.
إن استمرار إنكار السوريين لواقع الطائفية في البلاد لا يختلف كثيرا عن نهج “البعث” في طمس الهويات وقمع التعبير عنها. والاعتراف بهذا المرض السياسي والاجتماعي هو بداية العلاج، لا نقيضه. فجزء من الحل يكمن في بناء مؤسسات دستورية قادرة على تحويل تلك الانقسامات الطائفية من مصدر تهديد إلى إطار قانوني يضمن المساواة، ويحوّل الطائفة إلى مكوّن وطني لا إلى مشكلة أمنية. هكذا فقط يمكن للسوريين أن يشرعوا فعليا في بناء وطن يليق بتضحياتهم ويصون كراماتهم.
المجلة
———————–
========================