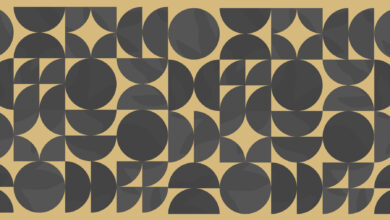الطائفية والاستراتيجية الإسرائيلية.. تفكيك سوريا/ عبد الله مكسور

2025.05.22
عندما ينكفئ النظام الدولي عن قيمه، ويُسلم زمام القيادة لمنطق الغلبة لا العدالة، تبدأ خارطة العالم بالاهتزاز على وقع هويات ضيقة، وتُصبح الطائفية والانتماءات الضيقة أداة لإعادة رسم الجغرافيا وحدود الاشتباك.
فالهوية حين تُختزل إلى ذاكرة جريحة، تصبح سلاحاً في يد من يعرف كيف يوظفها. في الحالة السورية، لم تعد إسرائيل مضطرة لإظهار أنيابها في اجتياحات تقليدية، فحضورها لم يعد عسكرياً ثابتاً ومباشراً، بل ناعماً، مراوغاً، متسللاً عبر التشققات الطائفية، ومن خلال فراغ الدولة التي تحاول تدريجياً استعادة المشروع الجامع والتمثيل الوطني. وفي مثل هذا السياق المتداعي، لا تعود الطائفية مجرّد انحراف اجتماعي أو أثر جانبي لتاريخ من الانقسامات أو الأزمات أو حتى الحرب الأهلية.
بيع الوهم الإسرائيلي
لم تعد تل أبيب بحاجة إلى أن تُقنع العالم “بمخاوفها” من جبهة جنوبية نشطة سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، بل يكفيها أن ترى “الوطن السوري” يتحول إلى فسيفساء مفككة، تتصارع فيها الكيانات على سلطة محلية خالية من الجوهر الوطني، وتنهض فيها الطوائف كملاذ للخوف لا كمكون منسجم ضمن كيان واحد. مدركةً تماماً أنه عندما يُفقد الإحساس بالانتماء الأوسع، يصبح صوت الجماعة الصغيرة أقرب إلى صراخ النجاة وطلب النجدة، بهذا الصراخ تتغذى الاستراتيجيات الإسرائيلية، فيُصاغ التدخل لا على هيئة صاروخ أو طائرة، بل على هيئة رعاية للمخاوف، ودعم للمظلوميات، ووعود بالحماية. وهكذا تُستثمر الطائفية لا بوصفها حتمية تاريخية، بل باعتبارها موردًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، يُعاد إنتاجه إسرائيلياً بلا كلل. فكلما تصادمت الطوائف، تقدّمت إسرائيل خطوة إضافية في مشروعها.
في الحالة السورية، تتجلى هذه المعادلة بوضوح حاد. إذ لم تعد إسرائيل، وهي أحد أبرز المستفيدين من هذا التفتت الإقليمي، في حاجة إلى حروب شاملة أو اجتياحات برية كما فعلت في بيروت عام 1982. بل تدخل من نوافذ الهوية المذعورة في لحظة تاريخية مضطربة بالنسبة لسوريا. تدرك تل أبيب، أن البيئة الأمنية التي تتيح لها لعب دور “الحامي من الخوف” هي أكثر نجاعة من أي احتلال عسكري قد ينهار أمام مقاومة أو متغير دولي. لذلك تسعى لخلق ظروف تجعل من التدخل المستدام ضرورة محلية قبل أن يكون قراراً خارجياً. إنها تفعل ذلك باسم “الحماية”، بينما جوهره يقوم على هندسة التفكيك الناعم، الذي يُبقيها حاضرة في الجغرافيا دون أن تظهر في الخرائط الرسمية. فنكون جميعاً في خريطة دولة تتفكك إلى كيانات رخوة، تتوزعها الولاءات المذهبية والمناطقية، وتفتقر إلى أي مشروع وطني جامع أو سردية وطنية قابلة للتوحيد. إسرائيل تدرك أن الدول لا تسقط فقط عبر الحرب، بل قد تسقط عبر “الهندسة الهادئة للهويات”، وهي تُتقن فنون هذه الهندسة.
إنها اللحظة الإسرائيلية المثالية، التي لا تحتاج فيها إلى الدبابات بل إلى خرائط تُعاد حضورها بهدوء فوق هشيم من الثقة الوطنية المتهالكة. “التفكك المستدام”، ذاك المفهوم الذي تحوّل من تكتيك إلى استراتيجية، هو الغاية التي تتطلع إليها إسرائيل في الحالة السورية: تفكيك الانتماء قبل الحدود، تفتيت الرؤية الجامعة قبل الجغرافيا، وترسيخ منطق الطائفة بوصفها الملاذ الأخير. في ظل هذا المشهد، يحضر تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المولود في الجولان السوري المحتل، كدليل واضح على هذا المنطق حين قال بوقاحة سياسية: “نهاية ما يحدث في سوريا هو أن تصبح دولة مفتّتة، ضعيفة، مجزّأة.” هذا التصريح لا يُقرأ بوصفه موقفاً عابراً، بل يعكس ما يمكن تسميته بالعقيدة الأمنية–الاستراتيجية لدى الدولة العبرية، ومفادة أن إسرائيل إسرائيل إلى القضاء على الدولة السورية، بل إلى إبقائها في حالة “اللا دولة”، لا قوية ولا موحدة، بل كيان مُعلّق بين الوجود والعدم. وفي هذا المسار، يتجلى ما يمكن وضعه في خانة رؤية الأمن القومي الإسرائيلي استراتيجياً: سوريا لا يُفترض أن تعود كيانًا موحدًا، بل يجب أن تبقى “معلّقة” بين الوجود واللاوجود، بين الدولة واللادولة، بحيث تتحوّل إلى حقل رملي من الهويات المنفصلة، يسهل إدارة صراعاتها، ولا يمكن لمخيلتها الوطنية أن تنهض من بين الركام.
تفكيك العصب الوطني
هذا لا يتحقق باجتياح عسكري أو باحتلال مباشر، تدرك إسرائيل أن أقوى أشكال التفتيت ليست تلك التي تحدث عبر الحرب، بل عبر إعادة تشكيل المخيال العام. من خلال سياسة “تفكيك العصب الوطني”. يتم ذلك عبر إعادة تعريف سوريا ليس ككيان سياسي، بل كـ”حيّز طائفي” يتنازع فيه الزعماء المحليون على تمثيل طوائفهم، لا على تمثيل الدولة. وبهذا المعنى، تصبح الجغرافيا قابلة لإعادة التشكيل، لا بالدماء وحدها، بل بالعقول والمخاوف والتمويل. ويُعاد إنتاج الخارطة، ليس وفق السيادة، بل وفق الهوية الضيقة، فتنهار فكرة الكيان الجامع، حتى لو بقيت العاصمة تحت علم الجمهورية. فالجماعة التي تتبنى الطائفية فقدت الثقة في فكرة الوطن، وتحولت ذاكرتها إلى أرشيف للمظلومية، وهذا ما يُنضِج ظروف التقسيم من الداخل. فعندما تنهار الرواية الكبرى، يخرج كل واحد من كهفه شاهراً سيفه أو عصاه دفاعاً عن روايته، هذا هو جوهر اللعبة الإسرائيلية: سحب الغطاء عن الرواية الجامعة، وترك الجميع يتصارعون على الخوف. من هنا تصبح الطوائف ليست فقط أداة للتمايز، بل وحدة هندسية جديدة تُرسم بها خرائط النفوذ. الطائفة، حين تُسلخ عن بعدها الثقافي والديني وتُختزل في سعي بعض أعضائها إلى تحويلها لهوية سياسية مهما كان الثمن، تتحول إلى وحدة قياس تستخدمها قوى الخارج لتحديد مصالحها. وفي هذا المربع تتفوّق إسرائيل على خصومها؛ لأنها لم تعد تحارب بالطائرات بل بالأفكار، لا تبني مستوطنات فقط، بل تبني ذهنيات ملوثة بالخوف والانعزال.
الخوف والانعزال المبني على المظلومية، والذاكرة المجتزأة، والانتماء المغلق كملاذ خوف، فإن هذا التكوين يُصبح منجمًا سياسيًا لا يُهدر. ومن خلاله، تُعاد صياغة القيمة المعيارية للوطن السوري بحيث يصبح خليطًا من الهويات الجزئية، تتحرك كل واحدة منها تحت وطأة التهديد المتخيل والمزعوم من الأخرى، وتبحث عن حماية لا في الدولة، بل في الخارج، حيث تقدّم إسرائيل نفسها، إلى جانب قوى إقليمية أخرى، كضامن “موثوق”. وهنا يتبدى جوهر التحول: لم تعد الطائفة إطارًا ثقافيًا أو دينيًا، بل تحولت إلى “وحدة سياسية قابلة للإدارة”، وإلى عنصر في معادلة إقليمية يُعاد من خلالها تعريف السيادة.
صناعة الطائفية
لا بد أن يدرك السوريون والسوريات أن الخطر لا يكمن في وجود الطوائف، بل في تحوّلها إلى نظام إدارة. كما جاء في أحد الأمثال الإسرائيلية: “حين يتقاتل الجيران، تبني إسرائيل السياج وتفتح بوابة خلفية لكل منهم”. إنها لا تصنع الطائفية من عدم، لكنها ترعاها بصبر سياسي طويل. لا تطلق شرارتها الأولى، لكنها تغذيها بالخوف والتمييز والتضليل. كل طائفة تُقدَّم لها إسرائيل باعتبارها الحامية من الأخرى، والشريك المحتمل، وحتى المُخلص من الفوضى. وهنا، يتداخل الأمني مع الإنساني، والسياسي مع الطائفي. فتُمنح الطوائف مساعدات “إنسانية”، وتُعالج جراحها في مستشفيات مموّلة، وتُدعم فصائلها المسلحة بذكاء ناعم، لا لتحقق نصراً، بل لتتوازن ضمن معادلة هشّة. وتصبح الخرائط الطائفية هي الأرضية الجديدة التي تبني عليها إسرائيل مشروعها في “الهلال الهشّ”، فكلما ازداد الانقسام، ازدادت القدرة على التدخل، ليس فقط جغرافيًا، بل بنيويًا ونفسيًا وثقافيًا.
لقد انتقلت العقيدة الإسرائيلية من منطق الاحتلال الكلاسيكي إلى ما يمكن تسميته بـ”الهيمنة الرمادية”، التي لا تُظهر وجهها القاسي، بل تختبئ خلف واجهات متعددة: حماية الأقليات، ومواجهة إيران، ودعم الاستقرار. وهي بذلك، تقدم خطابًا مزدوجًا: للداخل الإسرائيلي المضطرب، بأنها تحقق أهدافها من دون خسائر بشرية كبرى؛ وللخارج، بأنها شريك استقرار في منطقة مأزومة. لهذا نراها تطرح مشاريع من شاكلة “ممر داوود الاستراتيجي”/” ربط البحر الميت بالبحر الأحمر”. لا كخطط اقتصادية فحسب، بل كتحركات هندسية أمنية تحت غطاء التوازن المائي والجغرافي، وخلق عوازل بالمعنى العسكري قابلة للتوظيف لاحقًا في أي صراع. ويُعاد إحياء مخططات قديمة من أرشيف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تراهن على إدارة منطقة مفككة تقوم على الكانتونات، لا على الدول، وعلى التحالفات الوظيفية لا السيادة.
إنها عودة إلى منطق شمعون بيريز حين قال: “الشرق الأوسط الجديد لا يُبنى بالجيوش، بل بالشبكات”، لكنه هذه المرة يُبنى بشبكات الطوائف، لا شبكات التكنولوجيا. أما الطائفية، فهي هنا ليست انتماءً روحياً أو شعورًا دينيًا، بل منظومة إدارة، ونموذج تقسيم، وآلية لضمان استمرار العجز السياسي. مظلومية تُسندها ذاكرة موجّهة، وخوف متبادل يُكرّس الانفصال الوظيفي بين المكوّنات. وكلما طال هذا الانفصال، تأجلت أي فرصة لبناء مشروع وطني سوري متماسك. فتبدو إسرائيل أقل كقوة احتلال، وأكثر كمحور توازن. وتُعاد صياغة مفهوم “الحماية” ليتحوّل من الدولة إلى الخارج، ومن الجيش إلى “الضامن الإقليمي”. وتُخاض الحروب، لا من أجل توحيد البلاد، بل من أجل ضمان استقرار التفكك.
والنتيجة في كل هذا انهيار الدولة في مضمونها، لا في مؤسساتها الشكلية. أما الأخطر من الانهيار، فهو إعادة تعريف سوريا كحيّز طائفي غير قابل للحكم من الداخل، لكنه قابل للإدارة من الخارج. إنه نوع من الاستعمار الناعم الذي لا يرفع الرايات، بل يعيد ترسيم الوعي. يهمّش الوطنية لصالح المذهبية، ويستعيض عن السيادة بالوكالة، ويحوّل المقاومة إلى أزمة داخلية تُدار بدل أن تُطلق. ولن يكون هناك مشروع سوري جامع ما لم يتم تفكيك الرؤية الطائفية التي تعمل بوصفها ماكينة إعادة إنتاج للهشاشة، ومصنعًا دائمًا للارتهان.
إعادة إنتاج الخرائط
في الخطاب الإسرائيلي تجاه سوريا، يبرز تعبير “حماية الأقليات” ليس كمجرد “شعار إنساني”، بل كأداة استراتيجية متعددة الوظائف، تُستخدم لتغليف التدخل غير المباشر بغلاف أخلاقي زائف، ولإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية تحت عباءة العناية بالضعفاء. هذه الأداة ليست وليدة اليوم، بل تجد جذورها في سردية متكررة، بدأت مبكرًا بعد نكبة فلسطين، حين دفعت إسرائيل المجتمع الدرزي في الداخل المحتل إلى الاندماج القسري ضمن جهازها الأمني والعسكري عبر قانون الخدمة الإلزامية، في محاولة لخلق نموذج أقلية “موالية” تُوظَّف داخليًا لتفتيت الهوية الفلسطينية، وتُصدَّر خارجيًا كدليل على “تعددية الدولة العبرية”. ومع ذلك، قاومت الحركة الوطنية الدرزية هذا المسار لعقود، ورفض كثير منها الانخراط في مشروع يشرعن الاحتلال ويؤبد التمييز. وعادت هذه المعادلة إلى الواجهة حين صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل “ملتزمة “أخلاقيًا” بعدم السماح بحدوث “مجزرة ضد الطائفة الدرزية في سوريا”. لكن المفارقة الأخلاقية هنا فادحة: الدولة ذاتها التي تقونن التمييز ضد مواطنيها العرب، وتقصف المدنيين في غزة، وتُحاصر الفلسطينيين في الضفة، وتعتدي على لبنان وسوريا، تتحدث فجأة بلسان الراعي الإنساني! ما تسعى إسرائيل إليه ليس إنقاذ “طائفة محاصرة”، بل بناء نقطة ارتكاز داخل الخارطة السورية يمكن إعادة تفعيلها لاحقًا كوسيلة ضغط، أو كحزام أمني ناعم لا يتطلب وجوداً عسكرياً مباشراً. إنها سياسة استباقية تهدف إلى حياكة شبكة علاقات داخل سوريا تُمكّن إسرائيل من التحرك بمرونة حين تنضج الظروف. وكما قال تشرشل: ” في السياسة لا توجد صداقات دائمة، بل مصالح دائمة”، يبدو أن تل أبيب تسعى إلى صياغة مصالحها عبر تفكيك البنى الوطنية، لا مواجهتها. وهنا تندرج فكرة “سوريا المفيدة”، التي روّجت لها مراكز التفكير الاستراتيجي الإسرائيلية، باعتبارها الحصيلة المنطقية لتفكك الدولة السورية: طوائف تُحكَم ذاتياً، وكيانات تُغلّف نفسها بدروع مذهبية، وخرائط جديدة تُرسم داخل الخرائط القديمة. وهذا – بطبيعة الحال- لا يُعيد فقط إنتاج نموذج “سايكس–بيكو” بحروف طائفية هذه المرة، بل يجعل إسرائيل شريكاً في صوغ الهوية السياسية للمشرق، لا مجرد متطفل عليها. إسرائيل التي طالما خافت من أن تبقى “حارة يهودية وسط الوطن العربي”، تدفع الآن بكل قواها لجعل المنطقة تشبهها: فسيفساء طائفية وهويات متناحرة، تُدار عبر خطوط تماس لا حدود دولية، وتُبنى حولها علاقات “تبعية وظيفية”، لا شراكة وطنية أوقومية.
تهشيم الجغرافيا الهشة
في هذه البيئة، تبدو الطائفية وكأنها شكل من أشكال الحكم غير المُعلَن، تقوم على مظلوميات متبادلة، ومخاوف مزمنة، وشعور دائم بأن “الآخر” تهديد وجودي. وهنا تستثمر إسرائيل ليس فقط في الانقسام، بل في الحاجة إلى “الحماية”، وتُقدِّم نفسها كـ”قوة توازن” لا كقوة احتلال. وهذا هو أخطر أشكال التدخل: حين يتحول الخصم إلى ضامن، والمحتل إلى شريك، والمشروع التفكيكي إلى سردية خلاص. ومخاطر هذا التسلل الطائفي الإسرائيلي لا تقتصر على الداخل السوري، بل تمتد كأمواج دوّامة إلى الإقليم كله. فالهويات حين تُهشَّم، لا تبقى محصورة داخل الجغرافيا التي تنفجر فيها، بل تُصدِّر ارتجاجاتها إلى المحيط، خاصة في غياب المشروع المضاد. والسؤال المركزي هنا: من يردع إسرائيل؟ ليس فقط بالمعنى العسكري، بل بالمعنى الحضاري والسياسي؟ من يمتلك القدرة على تقديم نموذج دولة يتجاوز المذهب والطائفة والعِرق؟ دولة تُعيد تأسيس المواطن بوصفه كائناً سياسياً لا طائفياً، وتحميه بالعدالة لا بالولاء، وبالمساواة لا بالخوف؟
الفراغ العربي
اليوم، تتحرك إسرائيل في فراغ عربي قاتل، يفتقر إلى المبادرة والرؤية، وتتآكل فيه البنى القومية كما تتآكل الأطراف المتروكة في العاصفة. الأمم المتحدة نفسها، التي كان يُفترض أن تشكل مظلة شرعية، أصبحت عاجزة عن وقف المجازر أو الحد من الأطماع. وفي هذا الفراغ، تُعيد تل أبيب تموضعها، فتُبرر القصف بالحماية، والاختراق بالوساطة، والهيمنة بالاستقرار. وهذا ليس محض تكتيك؛ بل عقيدة متكاملة تقوم على “الهندسة الناعمة للهويات”. الردع الحقيقي لا يكون بالصواريخ وحدها. كما أن الرد على الطائفية لا يكون بطائفية مضادة، بل بتأسيس وطن يتسع للجميع. المشروع البديل هو في استعادة سوريا ككيان سياسي جامع، يحتوي مواطنيه دون استثناء، ويمنحهم شعوراً بالانتماء لا بالخوف. وحدها الدولة التي تتجاوز تقسيمات الولاء واللون الواحد قادرة على إعادة إنتاج معنى “الهوية الجامعة”، وقادرة في الوقت ذاته على إغلاق الباب أمام الطموحات الإسرائيلية، ومنعها من أن تتحول من فرضيات عسكرية إلى هندسة واقعية مستدامة.
فإسرائيل، كما يقول أحد جنرالاتها السابقين، “لا تخشى الخصوم الذين يملكون السلاح، بل أولئك الذين يملكون رؤية”. القوة التي لا ترافقها فكرة، تشبه السيف بلا يد. أما الفكرة التي تستند إلى مشروع وطني صلب، فبوسعها أن تُربك أقوى العقائد الأمنية. وقد قرأنا في الفكر الصهيوني أنَّ ما لا يمكن تحقيقه بالقوة، يمكن تحقيقه بالمزيد من القوة. لكن ما تخشاه إسرائيل اليوم، هو أن تولد في محيطها دولة تقول العكس: “ما لا يمكن الحفاظ عليه بالقوة، لا يستحق أن يُبنى بالقوة”. وفي هذه اللحظة تحديدًا، يكون الصراع ليس على الأرض فقط، بل على المعنى. على هوية المكان، على سرديته، وعلى من يملك الحق في تسميته وطنًا.
وطنٌ تديره دولة سورية جديدة قادرة على تجاوز الانقسام، وتبني مفهوم المواطنة على أساس العدالة لا الحماية. المشروع المضاد للخطوات الإسرائيلية العملية، يبدأ من الداخل. من إعادة تعريف سوريا كدولة لكل مواطنيها، دولة تقطع الطريق على كل مشروع تفتيتي، وتعيد للهوية معناها، وللسيادة كرامتها. وحدها هذه الدولة، بكل ما تتطلبه من شجاعة سياسية وخيال وطني، يمكن أن تُفشل الرهان الإسرائيلي وتُخرج تل أبيب من دور “المنقذ الإقليمي”. وإن لم يُكسر هذا المسار الآن، فإن الخارطة المقبلة للمنطقة برمتها تُرسَمُ في مراكز التفكير الأمني الإسرائيلي، ولن توقفها بيانات الإدانة والشجب والتنديد.
تلفزيون سوريا