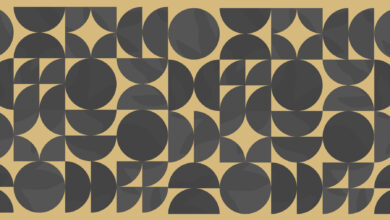سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 23 أيار 2025
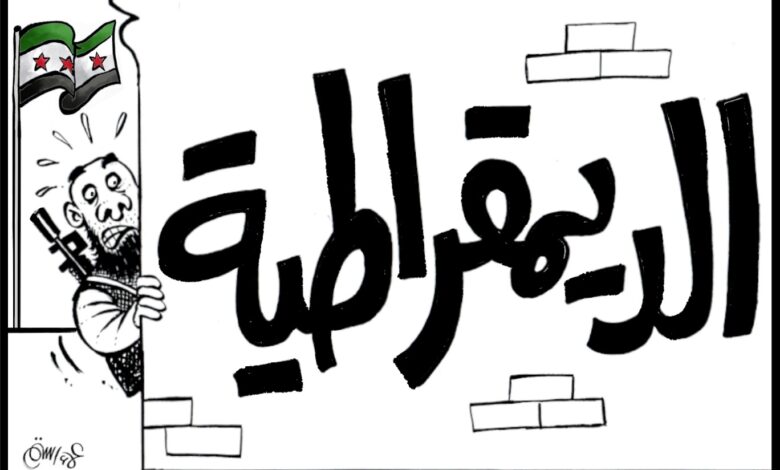
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————-
الحاجة إلى بناء الهوية الوطنية في سوريا الجديدة/ محمد شيخ يوسف
2025.05.22
أفرزت الثورة السورية على نظام الأسد البائد حراكا مجتمعيا سياسيا مختلفا عما كان عليه الوضع قبيل آذار/مارس 2011، إذ غيب نظام الحزب الواحد القمعي المجتمع على مدار عقود عن أي ممارسة سياسية حقيقية، وحصر الهوية الوطنية ضمن مفهوم طائفي أقلوي حزبي أدى إلى استبعاد شرائح وأطياف ومناطق عن المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والمجتمعية والسياسية، وهو ما تجلى واضحا في فترة ما بعد الثورة وبدء كل منطقة في سوريا التعبير عن نفسها وتنظيم صفوفها وترفع صوتها بقوة وتقول إنها موجودة، فظهرت لدينا المناطق والمجموعات والمكونات المغيبة، فكانت الثورة السورية العظيمة بالفعل ثورة الإنسان السوري وكرامته.
الحراك المجتمعي السياسي وإن كانت فيه تجارب غير ناجحة وأخرى تعرضت للتشويش متأثرة بضغوط المرحلة السابقة، وبقلة النضج السياسي ومزاولة العمل الاجتماعي، وبمنافع شخصية تارة، إلا أنها أظهرت نجاحا لدى كثير من التجارب، وهو ما أسهم في ظهور الهوية الوطنية السورية الجديدة القائمة على مقومات تضع الإنسان وحقوقه في المرتبة الأولى، ومصالحه وأمنه وحمايته، كخطوط حمراء لا تمس، وحرية معتقده ورأيه وثقافته كأساس لا يمكن التخلي عنه.
سوريا التي كان النظام يحصرها بمناطق محددة، وعبر شخصيات ومجموعات معينة، باتت لكل السوريين، شرق البلاد وغربه، ومن شماله وجنوبه، ليفرز وطنا جامعا لكل المواطنين تحت بند المساواة بين الجميع، وعادت سوريا لتتوحد مجددا وتجتمع لوحة الفسيفساء وتنضم للحكومة في دمشق، وتبقى المناطق التي تسيطر عليها قوى الأمر الواقع حاليا بعيدة، لكن عقارب الساعة تتجه إلى اقتراب عودة تلك المناطق لتشكل خريطة سوريا الموحدة.
وفي ظل الانقسام الذي كان النظام قد فرضه، بالتعاون مع دول ساندته، وبدعم من قوى انفصالية، ذاق السوريون إلى جانب تجربة الانتظام السياسي والاجتماعي والتعبير عن الذات، صعوبات التقسيم إلى كينونات ومناطق، وما حققت تلك من إيجابيات وسلبيات تختلف نسبيا من منطقة لأخرى، كانت سلبياتها كارثية على الجميع ونسبتها أكبر، وعانى جميع السوريين من تبعات هذا الأمر، كله يدفع السوريين حاليا إلى التمسك أكثر بوحدة البلاد، لتخف وطأة الحرب والانقسام، والاستفادة من سوريا الجديدة بعد النظام، والمرحلة الانتقالية التي تسير بشكل هادئ وبظل تحديات كبيرة، وانفتاح طاقة الأمل برفع العقوبات، وقرب بدء مرحلة إعادة الإعمار ودخول الاستثمارات، وهو ما يعني سنوات من البناء والعمل واستعادة الاقتصاد والأحياء المدمرة والبيوت والنهضة ولم الشمل وعودة المهجرين والنازحين والمغتربين، هي مراحل مهمة يحتاجها كل سوري.
هذه المرحلة الجديدة وبظل كل ما توفر من ظروف إقليمية ودولية تسهم في تعافي المرحلة المقبلة، تدفع بالحاجة إلى تبني جميع السوريين الهوية الوطنية الجديدة لسوريا الحديثة، هوية تشمل جميع المكونات والأعراق والأديان، من عرب وتركمان وأكراد وسريان، مسلمين سنة وعلويين ودروز، ومسيحيين، من كل الطوائف والأعراق والمكونات التي تشكل النسيج السوري، الكل سواسية متساوون في الحقوق المقدمة من قبل الدولة السورية والواجبات التي على عاتق الجميع، دون تمييز أو تفريق أو معاملة من أي درجة كانت، لا تفوق للمدينة على الريف، ولا المدن الكبرى على المدن الصغرى.
وخلال مرحلة بناء سوريا الجديدة، وأثناء عمل الدولة في المرحلة الانتقالية على مستويات متعددة من الحوار الوطني إلى الإعلان الدستوري المؤقت والحكومة في المرحلة الانتقالية والإعداد لطرح البرلمان المؤقت، يفهم كل عاقل أن هذه المرحلة هي مؤقتة وتعد حاجة لبناء الدولة بعد التخريب الممنهج من قبل النظام منذ أكثر من خمسين عاما، ولحين انتهاء المرحلة الانتقالية التي تشمل إعداد دستور جديد، وإجراء استفتاء عليه، وإجراء انتخابات جديدة تتمخض عنها حكومة تعمل على خدمة الشعب وتطبيق الدستور الذي يشمل الحقوق، يتعين على السوريين بكل أطيافهم ومكوناتهم العمل بشكل متواز على وعي الهوية السياسية والمجتمعة الجديدة في الدولة السورية الجديدة.
ومن أبرز ملامح الهوية الوطنية الجديدة اللازمة بشكل عاجل لجميع السوريين، وضع سوريا أولا أمام أي اعتبار، مرحلة البناء هذه تتطلب وعيا وصبرا ودعما للحكومة لإتمام المراحل الانتقالية، وصولا إلى تطبيق الديمقراطية والحرية التي طالب بها السوريون منذ 2011 وقالوا حينها الموت ولا المذلة، وحرية للأبد، وبالتالي يحتاج من السوريين الوعي بضرورة الصبر في هذه المرحلة لتقف البلاد موحدة مرة جديدة، والابتعاد عن الاستفزازات والانجرار وراء الشائعات، والتفكير مليا في أي فتن قد تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن فلول النظام على رأس عملهم بدعم من بعض الأطراف، ويسعون كل فترة إلى تخريب المرحلة الجديدة عبر فتن وأكاذيب وألاعيب وتلفيق الأخبار وممارسة التضليل والتشويش.
النقطة الثانية المهمة هي التآخي بين السوريين، وإدراك أن هناك مساواة بين الجميع، فلا يمكن لأي أحد أن يكون مفضلا عن أي شخص آخر، ولا فضل لأحد على الآخر إلا عبر التآخي المشترك، ولا يمكن لأي طرف أن يحتكر أي شيء، لأن السوريين جميعا وصلوا إلى هذه المرحلة بالصبر والثبات والمعاناة، ومن المؤكد أن كل سوري كانت له معاناة مختلفة، بالطبع لا يشمل هذا رجال النظام والفاعلين معه ومرتكبي الانتهاكات والجرائم، حيث إن السوريين في الداخل كانوا ضحية وعانوا، والسوريين في الخارج كذلك كانت لهم معاناة ليست بالهينة، فضلا عن آلام أهالي الشهداء والمغيبين والمختفين ومن فقدت آثارهم، كل السوريين عانوا وجميعهم يستحقون الحياة الكريمة، وبالتالي لا فضل لأي سوري، فالمعاناة كانت مشتركة ولا تجزأ.
أما النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، وهي وضع الهوية السورية قبل الانتماءات العرقية والدينية والطائفية، فالجميع سوريون متساوون بالحقوق والواجبات وبالتالي الاعتزاز بالهوية السورية والابتعاد عن المناطقية، فلا يريد أي أحد أن يكرر ممارسات النظام الإقصائية، فاليوم جميع المكونات والطوائف والمناطق والمدن، يشتركون مع بعضهم البعض في بناء الدولة السورية الجديدة، وهذا لا يعني بالطبع عدم الفخر بالانتماء إلى أي مكون أو طائفة أو مجموعة، هذا أمر مختلف تمام، بل إن مسألة الشعور بالهوية السورية والمساواة، تقلل من مخاطر التوترات والإحساس بالإقصاء، وبالوقت نفسه يحق للجميع الشعور بالفخر والاعتزاز بما ينتمي له من ثقافة ولغة ومعتقد، هذه هي مقومات الدولة الجديدة الديمقراطية راعية الحقوق والحريات للجميع، وهو ما خرج الجميع من أجله، وعدم الشعور بالاستبعاد في وطن يجمع الجميع.
كما يجب ألا ينسى السوريون أن تجارب الدول الحقيقية في الديمقراطية بالحرية والمساواة تضع الجميع على قدر واحد من المعاملة والمسؤولية، وحتى الوصول إلى هذه المرحلة يجب التحلي بروح الهوية الجديدة القائمة على هذا المبدأ، فلا تمييز بين أحد، كما تجري المعاملات في مختلف المؤسسات، والتعامل في الدول المتقدمة مع المواطنين وفق أرقامه الوطنية وحسب، ما يسهم في تقديم الخدمة لهم بشكل أفضل دون أي سؤال عن منطقة أو حي أو قرية او مدينة، وعليه يجب أن يتكاتف السوريون في المرحلة الجديدة لبناء الدولة بمعرفة الحقوق والواجبات، وبالطبع فإن هذا الموضوع كبير جدا ويمكن الحديث فيه بتفصيل، والأهم أن تكون كلها موجودة في الدستور الجديد المأمول، دستور يوفر الأمان والحرية والديمقراطية وكفالة حقوق جميع السوريين وضمان مساواتهم وتكافؤ الفرص فيما بينهم دون أي تفريق.
تلفزيون سوريا
——————————-
“الديمقراطية” الغائبة عن قاموس السياسة السورية الجديدة/ بهاء العوام
تساؤلات حول أسباب تجنب استخدام المصطلح في خطابات ولقاءات المسؤولين بدءاً من الرئيس
الخميس 22 مايو 2025
ملخص
تغيب كلمة الديمقراطية عن الخطاب السياسي في سوريا بعد سقوط الأسد، فلا يتطرق إليها أي مسؤول رسمي اليوم من أعلى الهرم إلى أسفله، وكأنها لعنة يتجنب الجميع ترديدها أو مخالفة للقوانين يخشون الوقوع فيها، وتتباين التكهنات حول الأسباب إن كانت دينية أو سياسية، ولكن النتيجة هي أن استحقاقات المصطلح تندرج ضمن مطالب الأطراف الخارجية المتابعة لعملية انتقال سوريا من الحكم الاستبدادي إلى عصر الحرية.
منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من خمسة أشهر لم تعُد تتردد كلمة الديمقراطية في أروقة أو خطب الساسة السوريين، على رغم أن القيادة الجديدة في دمشق تجسد معارضة لاستبداد حكم البلاد لعقود، فضاق الناس به ذرعاً وثاروا عليه، وبتعبير آخر، تمثل السلطة الجديدة بكل شخوصها ومؤسساتها عملية انتقال من الطغيان إلى العدل ومن التقييد إلى الحرية.
حرص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وجميع من كلفهم مناصب أو مهمات رسمية منذ وصوله إلى قصر الأمويين في دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، على عدم نطق كلمة “الديمقراطية” خلال خطبهم السياسية أو مقابلاتهم ومؤتمراتهم الإعلامية، وكأنها تنطوي على مخالفة للقوانين أو ترتبط بالنظام السابق أو تحيل إلى خطر يتهدد البلاد والشعب.
أول من أشار إلى غياب مصطلح الديمقراطية عن الخطاب السوري الرسمي بعد الأسد كان مجلة “فورين أفيرز” عبر مقالة نشرتها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولفتت فيها إلى أن شرعية سلطة دمشق الجديدة “ستستند في الغالب إلى تفسير سلفي يعتبر الكلمة علمانية وغير إسلامية”، لكن أيّاً كان التفسير الذي تتوقعه المجلة يبدو أنه لا يعجب “داعش”، فصحيفة النبأ المتحدثة باسمه قالت في افتتاحية العدد 490 إن “الخلاف بين التنظيم وأبي محمد الجولاني (الاسم السابق للرئيس الشرع) هو بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والديمقراطية”.
التنظيم الإرهابي يجد السلطة الجديدة في دمشق “ديمقراطية” على رغم أن كل مسؤوليها وموظفيها لا ينطقون بهذه الكلمة ولو على سبيل الخطأ في ترديد مصطلح ارتبط بثورة السوريين لنحو عقد ونصف، وهذا بحد ذاته يستدعي البحث عن تفسيرات لاختفاء الكلمة من قاموس السياسة في مرحلة ما بعد الأسد، وهل هو غياب لغوي فقط أم سلوكياً أم ممارسة أيضاً؟
ثمة تفسير خرج به حسن الدغيم، المتحدث الرسمي باسم “مؤتمر الحوار الوطني” الذي أطلقته حكومة دمشق في فبراير (شباط) الماضي، إذ قال خلال مقابلة عبر موقع إخباري إن “المرحلة الحالية تحتاج إلى العدالة السياسية أكثر من الديمقراطية، فأولويات جيل كامل من السوريين اليوم هي مغادرة مخيمات اللجوء والنزوح والعودة لمناطقهم ومنازلهم ومقاعد الدراسة، وهناك خشية أيضاً من الديمقراطية تتمثل في احتمال عودة أصحاب المال من الدول الغربية والعربية ليسيطروا على الحياة السياسية والأحزاب على حساب أولئك الذين قد تستمر معاناتهم لأعوام قبل إتمام إعادة إعمار مناطق كثيرة في البلاد”.
والدغيم يؤيد الديمقراطية لأن “لا أحد يخسر معها” وفق تعبيره، ولكن “المرحلة الراهنة قد تنطوي على حساسية من الأفضل مراعاتها”، منوهاً إلى أن “غياب المصطلح لا يعني غياب الحريات في البلاد، والديمقراطية بمعناها العملياتي الواقعي هو قول الناس ما يريدون من دون خوف، وهو ما يحدث اليوم في سوريا”، مع الأخذ في الاعتبار وجود تفسيرات ومقالات صدرت عن مفكرين إسلاميين خلال القرن الماضي أظهرت وجود تباين بين الدين والديمقراطية، مما صعّب على بعضهم استخدام المصطلح في سوريا ما بعد بشار الأسد.
المرة الوحيدة التي استخدم فيها الشرع كلمة الديمقراطية كانت في فبراير الماضي خلال مقابلة مع مجلة “إيكونوميست” ورداً على تساؤل حول غياب الكلمة عن الخطاب الرسمي للدولة الجديدة، فرد الشرع أن سوريا تمضي نحو “الديمقراطية التي تعني أن الناس يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم في البرلمان”، مشدداً على أن لهذا المصطلح تعريفات مختلفة في المنطقة من دون أن يحدد أي التعريفات يناسب المرحلة الراهنة الذي توقع أن تستمر لخمسة أعوام.
من وجهة نظر الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري ومديرة منظمة “دولتي” رولا بغدادي، فإن الشرع يتجنب استخدام “الديمقراطية” لأن “الفصائل التي شاركته إسقاط الأسد والسيطرة على الحكم لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدستور ولا حتى بنظام الدولة نفسه، فهي تعتقد فقط بالجهاد وأمة الخلافة والحكم الواحد في أماكن المسلمين بعموم المنطقة وليس فقط في سوريا”، بالتالي من الممكن أن يضع استخدام المصطلح الحكومة بمواجهة هؤلاء الناس، وسلطة الدولة لا تزال أضعف من السيطرة عليهم وضبط تحركاتهم، على حد تعبيرها.
وفيما ترى بغدادي في الخشية من الفصائل الجهادية حجة للهروب من استحقاقات تتطلب مشاركة السوريين في تقرير مصير دولتهم ومستقبلها، تتوقع أن تمضي البلاد نحو ديمقراطية توافقية على غرار لبنان والعراق، أي تقاسم السلطة بين الطوائف والقوميات، بديلاً عن إطلاق الساحة للعمل السياسي الذي يقود إلى دولة مواطنة يتنافس فيها الجميع بمنطق الكفاءة.
تستطرد بغدادي في حديث إلى “اندبندنت عربية” بأن ادعاء البعض بتوافق الشارع السني خلف الشرع من أجل تبرير ممارساته وخطواته نحو بناء الدولة ليس دقيقاً، فالرئيس الجديد “لا يحظى بتوافق سياسي والتشدد الذي يتلمس طريقه في سوريا اليوم لم نشهده من أي مكون سابقاً، وأية حاضنة سورية له لا تمثل الأكثرية ولا تعبر عن إجماع وطني”.
وبعيداً من استخدام “الديمقراطية” كمفردة، لم تصدر عن السلطة الجديدة أية إجراءات تترجم المصطلح وفق تعريفاته المعروفة، فتوضح بغدادي أن التعيينات والقرارات التي صدرت عن الشرع منذ توليه السلطة اتخذها بمفرده مع مراعاة اعتبارات إقليمية ودولية، لافتة إلى أن توافق الأطراف الخارجية على استقرار سوريا هو ما يبقي الأمل في أن يمضي الرئيس الجديد نحو الديمقراطية قولاً وفعلاً، مع مرور الوقت ووضوح جدية المطالبات بإشراك السوريين في بناء مستقبل دولتهم.
—————————–
سوريا ومحاولات إعادة شبح التقسيم/ رياض معسعس
22 أيار 2025
يقول ماوتسي تونع: «إذا أردت أن تفهم شعبا ما فعد إلى تاريخه»، وإذا أردنا فهم الشعب السوري وما يجري من أحداث على الساحة السورية لا بد من العودة إلى التاريخ. فسوريا هذه الأرض التي نشأت فيها الحضارات الأولى التي تعود إلى الألف العاشر قبل الميلاد، وتوالت عليها كل الحضارات من سريان وكلدانيين وآشوريين وكنعانيين وسومريين وأنباط وبابليين، قدمت للبشرية كل فنون الزراعة، واخترعت الحرف (أبجدية رأس شمرا التي أسست لكل لغات العالم) وكانت مدنها من أقدم مدن التاريخ، وعاصمتها دمشق هي أقدم عاصمة في العالم، وفيها كان مهد الأديان التوحيدية، ومنها انطلقت إلى العالم أجمع، وهي التي واجهت روما (الملكة زنوبيا) وكادت أن تحكمها، ومنها برز قياصرة حكموا روما (فيليب العربي، وجوليا دومنا الحمصية، سبتيميوس جيتا، إيل جبال، جوليا ميزا،) ومنها كان يمر طريق الحرير إلى أوروبا.
ومع الفتح الإسلامي ظلت سوريا في عهد الأمويين أقوى دولة في العالم لمدة قرن كامل، ومنها انطلقت كل الفتوحات ففي العام 711 كانت الجيوش العربية الإسلامية على تخوم الصين وفي قلب فرنسا، وقام الأمويون بتأسيس أعظم وأجمل حضارة في الأندلس عبر التاريخ حيث كانت مثالا للعلم والفن والتطور والتعايش السلمي بين الطوائف. ولهذه الأسباب كانت سوريا ضحية موقعها الاستراتيجي، ولازدهارها، وحضاراتها، فتقاطرت عليها كل الامبراطوريات الغازية من فرس ورومان وإغريق وتتار، ومغول، وصليبيين وسواهم خاصة بعد انحدار الدولة العباسية. في العام 1516 كان عاما مفصليا في تاريخ سوريا التي دخلت تحت السيطرة العثمانية بعد معركة مرج دابق ضد المماليك ولم تجل عنها إلا بعد الحرب العالمية الأولى. (1914ـ1918).
كانت سوريا الكبرى في العهد العثماني تشمل كل الأراضي التي كان يضمها ما سمي بالهلال الخصيب أي تيماء والجوف إلى تبوك وبادية الشام الممتدة إلى الكويت والأحواز وجزء من سيناء، وشمالا كانت الحدود تصل إلى ديار بكر وحران وأورفة ومرعش وكلس وعنتاب وأضنة ومرسين، والشام أي سوريا الحالية ولبنان وفلسطين والأردن. وقبل سقوط السلطنة العثمانية أشارت المراسلات الفرنسية البريطانية قبيل عقد اتفاقية سايكس بيكو إلى تثبيت الحدود الإدارية لسوريا بأن تشمل: ولايات ومتصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلب وفي الشمال الجزء الكامل من ولاية أضنة جنوب طوروس. وقد بدأ أول مشروع تقسيم في جسد سوريا بعد الحرب الأهلية الأولى في لبنان (بين الدروز والموارنة) في العام 1860 وقد طلب الموارنة الاستقلال الذاتي بدعم من الامبراطور لويس فيليب (نابليون الثالث) الذي ضغط على الباب العالي للموافقة على ما سمي «بمتصرفية جبل لبنان» تحت حكم متصرف أجنبي مسيحي عثماني. وهذه كانت الخطوة الأولى نحو سلخ لبنان عن سوريا بعد أن سيطرت فرنسا على سوريا ولبنان حسب اتفاقية سايكس ـ بيكو، ولما كانت فرنسا تعلم بأن بريطانيا تسعى لبناء دولة يهودية في فلسطين وسلخها عن سوريا (فكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين كانت فكرة فرنسية حاول تنفيذها نابليون بونابرت لكنه فشل على أسوار عكا) قامت هي ببناء دولة تقودها الطائفة المسيحية المارونية في لبنان. وقامت بريطانيا باحتلال فلسطين، وأنشأت دولة الأردن، وسيطرت على العراق. حسب مخرجات مؤتمر سان ريمو. وبعد السيطرة على سوريا قامت فرنسا بإعلان قيام 5 دويلات على أسس مناطقية، وإثنية، وطائفية، وهي حلب ودمشق وجبل الدروز، وجبل العلويين، ولبنان الكبير.
لكن السوريين رفضوا التقسيم وقاوموه بالثورة السورية الكبرى، وفي العام 1939 قامت فرنسا باقتطاع لواء اسكندرون من سوريا وضمه إلى تركيا كهدية لثنيها عن المشاركة في الحرب العالمية الثانية.
نالت سوريا استقلالها في العام 1946 ولأول مرة في التاريخ تتكون سوريا كدولة جمهورية مستقلة، وضمن دستورها مشاركة جميع أبنائها بجميع طوائفهم في كل مجالات الحياة ومثالا على ذلك لا الحصر:( 3 رؤساء جمهورية من الأكراد: حسني الزعيم، فوزي سلو، أديب الشيشكلي، وأمين عام الحزب الشيوعي خالد بكداش، وأشير إلى رئيس الوزراء المسيحي فارس الخوري الذي تبوأ منصب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمن وفي الوقت نفسه بتوافق مجلس النواب تولى منصب وزير الأوقاف الإسلامية، والمسيحي سعيد اسحق رئيس مجلس النواب، ومن الدروز مراكز كبيرة في إدارة البلاد، وفي الجيش السوري كفهد الشاعر، وسليم حاطوم، ومن العلويين محمد عمران، صلاح جديد، حافظ الأسد وسواهم) لكن منذ انقلاب البعث دخلت سوريا في نفق الدولة المخابراتية، وعبادة الشخصية، والاغتيال السياسي، والاعتقال التعسفي، وارتكاب المجازر المروعة، والأخطر الانقسام الطائفي الموجه من قبل السلطة الأسدية ضد الأكثرية السنية. والتوريث السياسي. وقد دام هذا الوضع في سوريا حوالي 60 سنة فككت عائلة الأسد خلالها نسيج المجتمع السوري، ودمرت اقتصادها، وبنيتها التحتية، ومئات الآلاف من المساكن المدنية، وقتلت أكثر من مليون شخص من المسلمين السنة باستخدام كل الأسلحة بما فيها الكيماوي، وهجرت أكثر من 12 مليونا منهم، وحولت سوريا إلى دولة مخدرات.
بدأ شبح التقسيم فعليا مع نظام الأسد باتخاذ سياسة الاعتماد على الطائفة العلوية في الحكم، وترهيب الطوائف الأخرى بخطر عودة الأكثرية السنية للحكم واستمالتها إلى جانبه، بل وضرب كل معارض لهذه السياسة حتى في صلب الطوائف الموالية التي منها ما كان معارضا.
وقد تجلت أولى ظواهر التقسيم بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011 بظهور تنظيم «داعش» الذي احتل الشمال الشرقي من سوريا، ثم ظهر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» الكردية التي بدأت تواجه فصائل الجيش السوري الحر المعارضة بتواطؤ من النظام الأسدي والتي وجدت أمريكا فيها ذراعا يمكن الاعتماد عليه في محاربة «داعش»، فنجحت باحتلال حوالي ربع مساحة سوريا شرق الفرات الغنية بالنفط بعد طرد «داعش» منها، وأقامت استقلالا ذاتيا في هذه المناطق ما أثار مخاوف تركيا بإقامة دولة تركية على حدودها فقامت بدعم فصائل المعارضة من الجيش الوطني الحر لتحرير بعض المدن والقرى التي سيطرت عليها «قسد» في شمال سوريا وتمكنت من تحريرها والسيطرة عليها، ونجحت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) مع فصائل أخرى منضوية تحت جناحها بتحرير محافظة إدلب من سيطرة النظام وإقامة إمارة غير معلنة استقلت أيضا ذاتيا وشكلت فيها حكومة مؤقتة معارضة. واستطاعت أمريكا السيطرة على منطقة التنف جنوب سوريا التي يتواجد فيها قوات معارضة من الجيش الحر. وهكذا تم تقسيم سوريا تحت سلطات مختلفة قبل أن تفاجئ هيئة تحرير الشام بدعم تركي بهجوم مباغت حررت فيه مدينة حلب ثم باقي المدن السورية وصولا إلى دمشق في وفرار بشار الأسد.
ولكن هذا لم يكن يعني أن السلطة الجديدة في سوريا التي وضعت دستورا جديدا مؤقتا يضمن الحرية والمساواة بين جميع السوريين قد سيطرت على الوضع تماما رغم توقيعها اتفاقا مع «قسد» (الذي لم يدم طويلا بعد المؤتمر الوطني الكردي الذي عقد في 26 نيسان/ أبريل الماضي وطالب بدولة لا مركزية) وقامت فلول النظام التابعة للطائفة العلوية بمهاجمة قوات الأمن من الإدارة الجديدة وطالبت بحماية دولية بل و«دولة علوية في الساحل السوري» وأعلن رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بتشكيل قوات نخبة لحماية الساحل، وفي محيط دمشق (جرمانا وصحنايا) وجبل العرب قامت وحدات مسلحة مشابهة بالاشتباك مع قوات الأمن في محاولة لعزل هذه المناطق والمطالبة باستقلال ذاتي أيضا مدعومين جهارا نهارا من إسرائيل التي شاركت في الاشتباكات، وأعلنت دعمها لدروز سوريا، وحتى أن البعض رفع علم إسرائيل، وقامت شخصيات دينية بزيارة إسرائيل بدعوة من شيخ عقل الدروز موفق طريف، لكن كما كانت هناك انقسامات لدى العلويين والأكراد ظهرت الانقسامات بشكل أوضح لدى الطائفة الدرزية.
هكذا تبدو سوريا مع كل هذه المحاولات التي تسعى لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة بمسميات الفيدرالية، أو الإدارة الذاتية بدعم إسرائيل التي صرحت بوقاحة وبلغة استعمارية إمبريالية أنها تسعى لتفكيكها أنها في خطر حقيقي يتربص بها لتحويلها لكيانات متناحرة تقضي عليها، وتكون بداية لتفكيك الشرق الأوسط و«إعادة صياغته» كما يصرح رئيس وزراء دولة الاحتلال بصلافة في كل مناسبة وغير مناسبة.
كاتب سوري
القدس العربي،
——————————
أينشتاين في مصياف/ علي سفر
2025.05.23
منذ زمن طويل، ينتشر بين هواة حل الألغاز والمسائل والمعادلات الرياضية المعقدة، لغزٌ يحمل اسم “أينشتاين”، يقوم على الطلب ممن يرغب في حله الإجابة عن سؤال: “من يملك السمكة؟”، بناءً على فرضية وجود خمسة بيوت، لكل واحدٍ منها لونٌ خاص به، ويسكنه شخص من قومية مختلفة، يشرب نوعًا محددًا من المشاريب، ويدخن تبغًا مختلفًا، ويربّي حيوانًا أليفًا.
اللغز يُقدِّم معلومة واحدة في كل بند من البنود السابقة، وعلى من يتنطّح لحلّه أن يبحث عن الإجابات الباقية، وصولًا إلى العثور على جواب للسؤال الرئيس.
يُوصَف هذا اللغز بأنه من أعقد التسليات الرائجة، ويعود هذا التقييم إلى عدّة عوامل؛ فهو يحتوي عددًا كبيرًا من العناصر المتشابكة، ويغيب عنه المعطى المباشر الذي يقود إلى الحل، أي أن على الشخص الذي يريد حله أن يصل إلى ذلك عبر الاستنتاج، وسط فوضى وضع المعطيات الباقية. حيث إن عليه بناء خريطة عقلية دقيقة، تقود إلى عملية تركيب مرحلي لعدد من الحلول الجزئية، وأن يتمتع بالصبر والتركيز، فدونهما سيُصاب المرء بالملل بعد أول فشلٍ يُصيبه.
على المستوى الشخصي، فشلت عدّة مرات في محاولة البحث عن إجابة للسؤال المطروح أعلاه، بسبب الاستعجال وقلة الصبر. لكنني حين عرفتُ طريقة الحل، وجدتُ أنني بحاجة إلى إعادة ترتيب آلية التفكير؛ فبدلًا من اعتبار اللغز أداة تسلية، يجب أن أتعاطى معه كمنشّط ذهني، يأخذ المشتغل فيه إلى إدراك حقيقة تقول إننا لا يمكننا الوصول إلى حلٍّ لأي معضلة دون أن نأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات العامة، وألّا نهمل -في سبيل ترسيخها- المعطيات الصغيرة والجزئية. وتبعًا لهذا، يصبح التمعّن في لغز أينشتاين، فيما لو عكسْتَه على الواقع المادي، أشبهَ بعملٍ سياسيٍّ معقد، يَطلَب منك أن توسّع رئتيك، كي تمتلك أدوات الحل.
لا يراد لهذه المقالة أن تأخذ القارئ إلى عتبة منوّعات وقصص غير جدّية، طالما أن كاتب هذه السطور يفترض بأن السوريين في هذه الأيام يحتاجون إلى حلحلة ألغازهم المحلية المعقّدة، بعد كل ما تم إنجازه على الصعيد الخارجي من تغيّرٍ في رؤية أغلب دول العالم تجاه القضية السورية؛ الأمر الذي نتج عنه رفع العقوبات المدمّرة لمساعي وجهود أي قوة تريد إصلاح حال البلد.
بل إن الهدف من إيراد قصة اللغز المنسوب إلى أينشتاين -دون دليل يثبت ذلك- إنما يتركّز حول استخلاص أسلوب معالجة للعديد من القضايا التي تبدو معقدة، ويظن كثير من السوريين أنها غير قابلة للتسوية، بسبب غياب أدوات الحل، واستحالة توفرها، ووجود قوى أخرى تدفع نحو تعقيدها أكثر.
منذ سقط نظام الأسد المجرم، وجدت المكونات السورية نفسها في دائرة قلق، وهذا أمر طبيعي بعد اعتياد آلية الإدارة عبر القمع والإرهاب، وتعطيل الذوات الخاصة لصالح “أنا” السلطة، التي التهمت الجميع تحت شعارات “اشتراكوية” وسيطرة عميقة إلغائية، انتهى وجودها على أرضية مذبحة دموية استمرت لمدة أربع عشرة سنة بشكلٍ متواصل!
كل طائفة، وكل جماعة، ترى الحياة من خلال لون بيتها، ومن خلال الانتماء الديني أو القومي، وبما تشربه، وبما تقتنيه من مقومات العيش، وغير ذلك. أي إنها تشبه في حالاتها ذلك التوصيف العبقري في اللغز. لكن إلحاح الأسئلة التي تبحث عن إجابات، ليس بالبساطة المتخيّلة، فحتى أولئك المنتشين بالنصر العظيم على وحشية العائلة الأسدية، لا يمتلكون تصورات عن آلية إعادة تركيب القطع المتفرّقة هنا، بما يصنع لوحة سورية متماسكة. ولهذا تراهم يُحيلون الإشكاليات وإلحاح أصحابها إلى نزقهم، وإلى رغبتهم في تعطيل مسار عمل الدولة الجديدة، بينما، لو أن هؤلاء الذين يُنافحون عن إدارة الرئيس أحمد الشرع يرون الأمور من أعلى قليلًا، ويتخلون عن اعتبار امتلاك القوة معيارًا لنجاح الإدارة، لوجدوا أن عليهم تكريس الجهد لمعالجة التفاصيل الصغيرة، من أجل دفع المكونات التي تنافرت بسبب الخلخلة الكبرى التي تسبب بها سقوط النظام، إلى التقارب أكثر فأكثر، من أجل صياغة عقدٍ جديد يجمعها مع بعضها، ويعيد بناءها وفق طموحات الثائرين الذين فجّروا التمرد على سلطة الأسديين الغاشمة!
قبل أيام قليلة، أنجز “المصايتة” -أي أهل مدينة مصياف- عملًا كبيرًا، يستحق أن يُنظر فيه؛ ففي ازدحام حياة السوريين بالإشكالات والإنجازات على حدٍّ سواء، كانت هناك فئة في هذه المدينة، التي تحتوي نسيجًا طائفيًا مختلطًا، تعمل من أجل اقتراح آلية تواصل بين السلطة وبين السكان، تقوم على إنشاء مجلس أهلي، يعمل من أجل مهام محددة وفق بيانه عن نفسه، كـالتحرّك بشكلٍ فاعل لمعالجة هموم وقضايا المجتمع، وبناء جسور تواصل مع المجتمع والسلطات على حدٍّ سواء، وتركيز الجهود على حفظ السلم الأهلي، والسعي لتحقيق العدالة الانتقالية في سبيل بناء الدولة السورية الجديدة.
العمل الذي أنجزه ناشطون وفاعلون من المدينة، من خلال آلية انتخابية في اجتماعٍ حضره 138 شخصًا من مختلف الفئات العمرية، يمكن اعتباره واحدًا من أبرز الإنجازات التي يؤديها المجتمع المدني في البيئات المحلية السورية في الظرف الحالي، الذي تغيب فيه -بسبب الوضع الانتقالي- القدرة على تنفيذ انتخابات ديمقراطية لسلطة الإدارة المحلية. فبدلًا من ترك الأمور فضفاضة، وترك حبل اتخاذ القرارات على الغارب، والسؤال عن حلٍّ للغز المستقبل، يجب على المجتمع المدني (الأفراد والجمعيات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية وغيرها) أن يملأ الفراغ بما يمكنه أن يفعله. وعبر هذا النهج، يبني السكان المحليون واجهاتهم التمثيلية، دون انتظار قرارات تُسقَط عليهم من الأعلى، كما أنهم يُوفّرون على الإدارة الجديدة جهدًا كبيرًا في البحث عمّن يمكن التعامل معه ليكون معبّرًا عنهم، أو صلة وصلٍ معهم!
هذه التجربة تبدو واعدة، وتُحرّض الآخرين على اعتبار ذات الأسلوب. وإذا تمكنت من الانتشار كعدوى إيجابية في البيئات المضطربة، التي تشكّل فيها قصة التمثيل إشكالًا كبيرًا يرقى إلى حالة اللغز، فإن السبيل إلى خلق أرضية الحل يصبح بيد السوريين، كلٍّ في بيئته، وفي فضائه.
تلفزيون سوريا
——————————–
“انتخابات” بمصياف.. تدشن أولى مبادرات إنعاش المجتمع المدني/ محمد كساح
الخميس 2025/05/22
يمكن وضع الإعلان عن تشكيل مجلس مصياف الأهلي، في سياق محاولات أولية لتعزيز المجتمع المدني في سوريا بعد عقود من تغول السلطة على الدولة والمجتمع، لكن هذه الخطوة تواجه في حال تعميمها عقبات كبيرة، على رأسها احتمالية سوء فهم السلطة الانتقالية لها، فضلاً عن إنتاج نماذج تقليدية من المحسوبيات.
انتخابات جريئة
وكان ناشطون وفاعلون من مدينة مصياف، قد عقدوا اجتماعاً موسعاً لانتخاب مجلس مصياف الأهلي، حضره 138 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، وتنضوي مهام مجلس مصياف الأهلي، وفقاً لبيان صادر عن المجلس، على التحرك بشكل فاعل لمعالجة هموم وقضايا المجتمع، وبناء جسور تواصل مع المجتمع والسلطات على حد سواء، كما يركّز جهوده أيضاً على حفظ السلم الأهلي والسعي لتحقيق العدالة الانتقالية في سبيل بناء الدولة السورية الجديدة.
وتقول ندى الخش، إحدى المشاركات في هذه الفعالية، إن التجربة كانت “ثمرة حوارات طويلة مجتمعية بعد انهيار حكم الأسد والفراغ الذي عاشته مصياف ريثما تبدأ السلطة الجديدة في إدارة البلد”. وتضيف لـ”المدن”، أن “الحوارات وصلت إلى أهمية وجود مجلس أهلي يكون بمثابة المرجعية للمجتمع الأهلي فيما بينه وبين السلطة بحيث تنتظم العلاقات توفيراً للوقت ومنعاً لانتشار للفوضى والحد من الإشاعات”.
وتلفت الخش إلى المتاعب التي واجهت انتخاب المجلس المحلي والتي تمثلت في “التهميش الطويل للمجتمع وخشية السلطة من التجمعات خوفاً من أي اختراق لا تحمد عقباه، لا سيما وأن الظروف الأمنية لسوريا لم تستقر جيداً”. وتوضح أن “التجربة لاتزال في بداياتها وتحتاج إلى خطط عمل واقعية كي تتحول من الحوار إلى الفعل الشعبي وإلى اعتراف رسمي بها كي لا تصطدم بالسلطة وتتراجع عن دورها الأهلي”.
تجارب أخرى
وفي خطوة مشابهة لكن على نطاق أضيق، يحاول ناشطون تفعيل دور المجتمع المدني في قرية البريخية بريف طرطوس. ويقول الأكاديمي والكاتب والمشرف على المبادرة منير شحود، لـ”المدن”، إن البداية كانت بدعوة عشرات الأشخاص من الجنسين لتنشيط دور المجتمع المدني الذي يتمثل بكونه وسيطاً بين السلطة والمجتمع، وتم تقسيم المجموعة إلى لجان تخصصية، كما تم انتخاب منسقي الفرق في معظم الحالات وليس في كلها في هذه المرحلة، وحتى استقرار التجربة.
ويضيف أن المبادرة تهدف إلى “الارتقاء بالمجتمع الأهلي إلى مرحلة أعلى من مجتمعات ما قبل الدولة بحيث تمثل جميع المواطنين”، معتبراً أن “دور المجتمع المدني مهم جدا لكنه لا يتلاءم مع الدول غير الديمقراطية”.
ويرى شحود أنه في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، لا يمكن معرفة مصير مبادرات المجتمع المدني في نهاية المطاف، مؤكداً أن “المشرفين على المبادرة لم يتعرضوا لأي تدخل غير إيجابي حتى الآن، خصوصاً أن مثل هذه المبادرات لا تتعارض مع الإعلان الدستوري وتوفر على الدولة صفة تمثيلية مهمة جداً، حيث يخرج المجتمع المدني صوتا تمثيليا حقيقيا يصل إلى السلطة بعد تغييب كبير لدوره خلال العقود الماضية”.
ويشير شحود إلى النتائج السريعة التي لمستها البريخية في ظل هذه المبادرة، من خلال تنظيم الفعاليات ومشاركة الإناث بنسبة تقارب 80%، ما يدل على أن المجتمع الأنثوي لم يتحطم في الحرب بخلاف المجتمع الذكوري.
تساؤلات جوهرية
وتعليقا، يرى الدبلوماسي المستقل في “مؤسسة الوساطة وتحويل النزاع” في فيينا عزت بغدادي، أن تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه الانتخابات ومشروعيتها تقف خلف هذا المشهد الإيجابي، مشيراً في حديث لـ”المدن”، إلى أنه “يتعين مراعاة ثلاثة معايير أساسية لتقييم التجربة وهي طريقة التشكيل، والأفراد المكونين، والكفاءة”.
وبالنسبة للأفراد المكونين، يوضح بغدادي أن بعض المنتقدين يرون أن عدداً من الفائزين يعيدون إنتاج نماذج تقليدية من المحسوبيات، حيث لا يزال الصوت النقدي مرفوضاً، وأي محاولة لإبداء الرأي المخالف تواجه بردود دفاعية أو تبريرات.
أما فيما يخص الكفاءة، فيرى أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة المجلس الجديد على تجاوز الأطر التقليدية، والتحرك بشكل فاعل لمعالجة قضايا المجتمع، وبناء جسور تواصل مع السلطات بشكل مستقل عن المحسوبيات والولاءات.
المدن
——————————-
حول إيلي كوهين وأحمد الشرع/ سهيل كيوان
22 أيار 2025
أكثر قصص الجاسوسية شهرة بين العرب وإسرائيل، هي قصة إيلي كوهين الذي عُرف باسم كمال أمين ثابت، والذي زُرع في سوريا عام 1962، كتاجر سوري عائد من الأرجنتين إلى وطنه، وبسرعة أصبح مقربا من الدائرة الضيقة الممسكة بزمام السلطة حتى كُشف أمره عام 1965 وجرى إعدامه في دمشق. في الأيام الأخيرة أعلن الموساد نقل أغراض تخص إيلي كوهين، قدرت بـ2000 غرض، من بينها مفاتيح شقته ووثائق مكتوبة، منها وصيته إلى زوجته، وقرار الحكم عليه وغيرها. أثارت عملية إعادة أغراض كوهين إلى يد الموساد، تساؤلات حولها، وكيف تمت، وما الثمن الذي دُفع مقابل هذا؟ البعض يرجح أنها كانت واحدة من شروط صفقة رفع العقوبات عن سوريا، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب! قد يكون هذا صحيحا، وإذا كان هذا مقابل رفع عقوبات اقتصادية تمس حياة ملايين السوريين فلم لا؟ بل لم لا تعاد رفات إيلي كوهين إذا ما عرفت الحكومة الحالية مكانها، في إطار رفع العُقوبات، أو أي صفقة أخرى تعود بالفائدة على السوريين؟
كذلك ليس من المستبعد، أن هناك مسؤولا كبيرا من النظام السابق أو الأسبق يعرف مكان هذه الأغراض، وقبض ثمنا مقابل تسليمها، أو الكشف عن مكانها ثم نقلها. كل هذا جائز، إلا أن البعض ذهب إلى أن هذا يعزز نظرية، أن الرئيس أحمد الشرع في الواقع هو صناعة أمريكية – إسرائيلية، وأن وصوله السلطة لم يكن صدفة، بل جرى إعداده ودسه في صفوف «داعش»، ثم جبهة النصرة، فهيئة تحرير الشام، إلى أن أمسك زمام الأمور في سوريا، حسب الخطة. ويذهب البعض إلى أن الشرع هو مشروع إيلي كوهين جديد، ولكن هذه المرة بنجاح وصوله إلى رأس السلطة. كان آخر التصريحات، التي أمدت هذه التشكيكات بدفعة جديدة، هو حديث روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في سوريا عن لقاءاته ومسؤولين أمريكيين بالشرع في المناطق المحررة مثل إدلب. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أوضح، أن هذه اللقاءات كانت مثل لقاءات كثيرة في المناطق المحررة، كان يزورها مسؤولون أجانب بهدف الاطلاع على ما يجري، وعلى تجربة الثورة السورية، ومن واكب أحداث الثورة السورية يذكر هذه اللقاءات والجولات.
تأتي هذا الهجمة ضمن الهجمات الأخرى الكثيرة من جهات مختلفة، أكثرها يهدف إلى شيطنة الشرع، على أمل استعادة التجربة الانقلابية على الدكتور محمد مرسي في مصر. من خلال التشكيك به، وإبراز عجز الحكومة السورية الانتقالية عن تقديم الأساسيات الحياتية للشعب السوري من عمل ومواد أساسية، وإظهار الوضع على أنه كما كان من قبل، وأن الذي أردنا التخلص منه عاد إلينا بثوبٍ جديد. بعض الهجمات على الشرع ترتدي أقنعة المطالبة بديمقراطية غير قابلة للتأجيل، ولا حتى للتفاوض، ولا لمرحلة انتقالية، يريد هؤلاء تعددية حزبية وحريات مُطلقة على طريقة دول أوروبية تعيش تجارب ديمقراطية، بدأ بعضها منذ القرن التاسع عشر، وبعضها تأسس بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبعضها عزز ديمقراطيته بعد سقوط الفاشية والنازية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وولد بعضها بعد انهيار منظومة الدول الاشتراكية التي بدأت عام 1989 وحتى تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991. بعض المطالبين بالديمقراطية في سوريا صادقٌ في نواياه وتوجهه، وهذا حقٌ، وهذا ما يحلم به كل إنسان متنور لسوريا، ولكل الوطن العربي، الحريات الشخصية، وفصل الدين عن الدولة، وأن تكون حقوق الفرد هي محور هذه الديمقراطية، ومساواة الجميع تحت قوانين مدنية واحدة، من هؤلاء من ناضلوا ضد النظام السابق، كل من موقعه، بتضحيات أقل أو أكثر، ولأجل هذا الهدف نزفت دماء وأرواح مئات آلاف السوريين، وأودع مئات الآلاف في السجون. لكن البعض يطلق شعار الديمقراطية، الآن وليس غدا بهدف واحد ووحيد، هو إسقاط نظام الشرع وحكومته، ووصف البلاد بتورا بورا وقندهار، يرافق هذا تزييف حقائق تجري على الأرض، مثل تلقف حادثة حب بين شاب وفتاة من طائفيتين مختلفتين، وادعاء اختطاف الفتاة وبيعها كجارية، وهذا تلفيقٌ واضح، دحضته الفتاة نفسها. ما يفعله هؤلاء، هو تلاعب غير مسؤول بالنار، لأن إسقاط الحكومة الانتقالية بالتخريب والدعايات السامة سيؤدي إلى فوضى، وتجدد الحرب الأهلية التي لن ينجو من لهيب نيرانها أحدٌ، مع التأكيد على أن ملايين السوريين ممن ذاقوا ويلات النظام السابق، لن يفرطوا بالنظام الجديد، وسوف يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة، خصوصا أن التجربة ما زالت في بدايتها، ومن حقها أن تأخذ فرصتها لإثبات جدارتها أو فشلها. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي حذر في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي من حرب أهلية وشيكة، وأن سقوط نظام الشرع سيؤدي إلى تقسيم سوريا، جاء هذا في سياق جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، لدفع عملية رفع العقوبات التي يحتاج بعضها موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، ولا يكفي قرار الرئيس ترامب وحده. تأتي هذه التصريحات لتسريع عملية رفع العقوبات عن سوريا قبل فوات الأوان، ومن ضمنها دعوة الحكومة السورية إلى إنهاء التحقيق ومحاسبة الفئات التي ارتكبت تجاوزات في أحداث الساحل السوري قبل شهرين، والتي قُتل فيها أبرياء.
رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا يعطي دفعة أمل قوية للاقتصاد السوري، وهذا يعني تغيير أحوال الناس إلى الأفضل، وأن أكثرية الشعب السوري سوف تساند الرئيس أحمد الشرع، ولن تفرط به وفي نهجه العملي لإخراج البلاد من محنتها. الديمقراطية لا تُبنى في ليلة وضحاها، ولا في بلد منهار اقتصاديا ومتقاطب طائفيا ومهددٌ بالتدخلات الأجنبية، ويرفض ملايين من مُهجريه العودة إلى بلدهم، لأنه ما زال مضطربا وغير آمن. الديمقراطية في صورتها المثالية ما زالت بعيدة، ولكن حتى لو جرت انتخابات، حسب نظام حزبي اليوم، فهل يتوقع أحدٌ فوز شخصٍ آخر غير أحمد الشرع؟ على أولئك المخلصين في دعوتهم إلى نظام ديمقراطي أن يصلوا إلى هذا الهدف، ضمن الدستور الجديد الذي يتيح إقامة الأحزاب السياسية، وأن يدلوا بمواقفهم وآرائهم ورؤاهم للتغيير الديمقراطي المنشود، من غير التحريض وبث الضغائن الطائفية والانقسامات. على من يريد الخير والتعايش مع أبناء بلده، أن يحجم عن التحشيد والتحريض الطائفي وعن الشتائم والإهانات والاستفزازات. هناك الكثير مما ينشر بصورة مقصودة لزيادة التحشيد الطائفي والمذهبي والتوتر ونكء الجراح، الكثير منه ليس من السوريين، بل هنالك مجموعات ذبابية تريد بالسوريين وسوريا شرا، وهناك أيد عابثة تتحرك في الظلام لزرع الفِتن مثل منشورات تدعو المسيحيين لاعتناق الإسلام وإلا.. وغيرها.
قبل يومين وبمبادرة الأمن السوري العام أزيلت لافتة عن أحد المكاتب كُتب عليها «سوريا في القمة، هنا وعدتَ وصدقتَ في وعدك وعهدك أيها القائد». أزيلت اللافتة منعا للعودة إلى شعارات تقديس الفرد. من يفتقد للثقة بنفسه يحتاج إلى مشاهدة الجماهير ترفع صورته وتنشئ له التماثيل في الساحات وتهتف له برضاها، أو مُرغَمة، أما الواثقُ من نهجه ونفسه وجمهوره، فلا يحتاج إلا لتعاون الجميع بروحٍ من الصدق والمسؤولية والتراحم فيما بينهم، وبث روح المحبة بدلا من الكراهية والشيطنة والصهْيَنة، حتى بلوغ البلاد والشعب إلى نقلة نوعية في الديمقراطية العميقة والراسخة، التي لا تزعزعها العواصف والمِحَن، ولا تختطفها نرجسيةٌ أو جنونُ عَظمةٍ لدى هذا القائد أو ذاك.
كاتب فلسطيني
القدس العربي،
———————————-
التحولات في العلاقات السورية اللبنانية: مسار يواجه تحديات/ عبد الله البشير
22 مايو 2025
في تصريحاته قبل يومين خلال لقاء جمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سورية، مؤكدًا دعم لبنان للجهود الهادفة إلى حفظ وحدة سورية وسيادتها، وحرصه على قيام أفضل العلاقات معها، وأهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. في تصريحات تأتي بعد سلسلة من الخطوات الإيجابية التي جرت بين الحكومتين اللبنانية والسورية، عقب سقوط نظام الأسد، بهدف إزالة العوائق والعقبات أمام علاقات أكثر استقرارًا بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، وذلك بعد سنوات من التوتر في العلاقات اللبنانية السورية، ومحاولات نظامي حافظ الأسد وابنه المخلوع بشار للتدخل في الشأن اللبناني وبسط النفوذ والوصاية.
وبدأت العلاقات السورية اللبنانية تشهد تحولًا تدريجيًا نحو مسار أكثر توازنًا، لتأخذ منحى تنسيق وتشكيل أولويات على مستوى رئاستي الدولتين، ومناقشات ضمن ملفات عدّة بهدف إيجاد حلول متوازنة لها. وترسم التفاهمات اللبنانية السورية في الوقت الحالي خطة نحو استقرار فعلي، وفق ما أشار إليه الباحث رشيد حوراني خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، مبينًا أن نهج الحكومة السورية في الوقت الحالي سياسة “صفر مشاكل” مع الدول العربية والدول المجاورة، وقد انفتحت على الجميع دون تحميل حكوماتهم مسؤولية سياسات بعضهم خلال وجود نظام الأسد، ومن ضمنهم لبنان.
وأوضح حوراني أن العلاقة مع لبنان بعد سقوط النظام البائد شهدت محطات إيجابية متعددة، كتسليم بعض الفارين من جيش النظام المخلوع، والتعاون في ضبط المعابر بين الجهات المختصة، وزيارة مسؤولين سياسيين وعسكريين لبنانيين لسورية. وقال: “يأمل لبنان تحسّن الوضع واستقراره في سورية لتحسّن اقتصاده أيضًا، ومن خلال ما سبق سيُعمَل على معالجة الملفات التي تعتبر عائقًا وشائكة إلى حد ما، كملف الموقوفين السوريين في رومية”.
وأشار حوراني إلى أن تطوّر العلاقة بين سورية ولبنان يجري بجهود سعودية، مضيفًا: “يعود هذا التقدير لرعاية السعودية الاجتماع الذي عقده وزير دفاعها مع كل من وزير الدفاع السوري ووزير الدفاع الوطني اللبناني، وبالتالي فإن العلاقة تبدأ أمنية بحل ملفاتها، وتتطوّر إلى بقية الملفات”.
ويثير أستاذ القانون الدولي والمحامي في محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، إيلي حاتم، تساؤلات عن تهديدات تعوق استقرار العلاقة بين سورية ولبنان. وقال لـ”العربي الجديد”: “منذ سنوات عديدة، وتحديدًا منذ قيام الكيان الصهيوني، ثمة مشروع يُراد من خلاله تفكيك منطقة الشرق الأدنى والأوسط إلى كيانات طائفية ودينية وعرقية، تدور في حلقة من الصراعات المزمنة والمتواصلة فيما بينها”.
وأضاف حاتم: “السؤال الجوهري الذي يُطرح اليوم هو: هل ستتمكن سورية من بلوغ الاستقرار فعلًا؟ أم أننا سنشهد تصاعدًا جديدًا في النزعات الانفصالية، مقرونًا بعودة أشكال متطرفة من الإسلام السياسي؟ مثل هذا السيناريو من شأنه أن يهدد إمكان قيام علاقات طبيعية ومتوازنة بين سورية ولبنان، وقد يعيد المنطقة إلى دوائر من التوتر وعدم اليقين”.
وأوضح حاتم أن انخراط سورية في الشأن اللبناني لم يكن بمعزل عن تأثيرات القوى الدولية، فقد شُجِّع حافظ الأسد آنذاك من قبل بعض الدوائر الغربية – وربما بدفع مباشر من هنري كيسنجر – على اعتماد توجهات إقليمية، خصوصًا تجاه لبنان. ولم تبدأ سورية باعترافها الكامل بسيادة الدولة اللبنانية وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها إلا في عهد بشار الأسد.
وقال حاتم: “لقد استُخدم الوجود السوري في لبنان من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية أداةً لإعادة رسم توازنات المنطقة، وإضفاء نوع من ‘الاستقرار المؤقت’ بعد حرب طويلة، ولا سيما بعد عام 1990، حين منحت العواصم الغربية، وفي طليعتها واشنطن وباريس، ضوءًا أخضر لدور سوري وازن في لبنان”، مشيرًا إلى تحقق هدوء نسبي لفترة من الزمن، إلى أن انقلب المشهد بعد غزو العراق عام 2003، لتتسارع بعدها الأحداث، ونصل إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005.
وحول آليات وضع العلاقات السورية اللبنانية على الطريق الصحيح، أشار حاتم إلى أن سورية القوية والموحدة، القادرة على حفظ كيانها من التفتت، يمكنها أن تؤسس لعلاقات متوازنة وطبيعية مع لبنان. وقال: “التجزئة والتشرذم لا يقودان إلا إلى الفوضى والاضطراب”. وتابع: “من هذا المنطلق، يجب أن يكون الالتزام المتبادل بين البلدين قائمًا على احترام السيادة الكاملة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل معًا من أجل ضمان أمن كل منهما واستقراره. وفي الخلاصة، يبدو أن مستقبل البلدين، للأسف، مرهون إلى حد بعيد بمعادلات إقليمية ودولية معقدة، وبصراعات مصالح بين قوى كبرى تمارس نفوذها على الأرضين، اللبنانية والسورية، على حد سواء”.
وختم حاتم بالقول: “من هنا، تبرز الحاجة إلى توعية الرأي العام، في كل من لبنان وسورية، على مخاطر هذه المشاريع العابرة للحدود، والسعي المشترك لحماية ما تبقى من مؤسسات الدولتين، اللتين جمعهما دائمًا تاريخ مشترك ومصير واحد”. يُشار إلى أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ونظيره اللبناني ميشال منسى، وقّعا اتفاقًا أكّدا فيه أهمية ترسيم الحدود وتشكيل لجان قانونية متخصصة في عدة مجالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” في مارس/آذار الماضي، وقد سبَق الاتفاق مباحثات أمنية بين الطرفين شملت ملفي الحدود واللاجئين.
العربي الجديد
——————————-
فورد وروبيو: أميركا المتحمّسة للاستحواذ على مستقبل سوريا
الخميس 2025/05/22
لم تكن المرّة الأولى التي يخرج بها السفير الأميركي السابق إلى سوريا، روبرت فورد، بموقف يثير الكثير من الجدل. في ظل تحولات كبيرة وكثيرة غالباً ما كانت تخرج من الولايات المتحدة الأميركية مواقف أو تسريبات أو تصريحات تنسب إلى مسؤولين أميركيين تحدث جدلاً وتخلط الأوراق. بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، جاء كلام فورد بالتوازي مع شرح مفصل قدمه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام الكونغرس، لخلفيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن دمشق، والتعامل بإيجابية مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وإعطاء سوريا فرصة جديدة.
موقف وزير الخارجية الأميركي نُقل بطريقة تحمل الكثير من الالتباسات، خصوصاً عندما نقل عنه أن سوريا مقبلة على حرب أهلية أو تفكك للدولة وللمجتمع، علماً أن تصويب الموقف جاء ليشير إلى أن هذا العرض كان في معرض تبرير خطوة رفع العقوبات.
يقول فورد “دعتني مؤسسة بريطانية غير حكومية، متخصصة في حل الصراعات، من أجل مساعدتهم في إخراج هذا الشاب (يُشير إلى صورة الشرع حين كان عضواً في تنظيم القاعدة) من عالم الإرهاب وإدخاله إلى عالم السياسة التقليدية”. وأردف الدبلوماسي الأميركي السابق قائلاً: “وعلي أن أخبركم أنني في البداية كنت متردداً جداً بالذهاب، وتخيلت نفسي مرتدياً بدلة برتقالية والسكين على رقبتي، لكن بعد أن تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين خاضوا التجربة وأحدهم قابله (الشرع) شخصياً قررت أن أجرب حظي”.
وتابع فورد قائلاً: “عندما التقيته للمرة الأولى، حين كان اسمه الحركي الجولاني، لكن اسمه الحقيقي الذي لم يكشف عنه إلا بعد السيطرة على دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل حوالى 5 أشهر هو أحمد الشرع، جلست بجانبه بمثل قربي الآن إلى روي (رئيس مجلس بالتيمور) وقلت له باللغة العربية: خلال مليون سنة لم أكن أتخيل أنني سأكون جالسا بجانبك… ونظر إلي وتحدث بنبرة ناعمة قائلاً: ولا أنا”.
بدا الكلام وكأنه إيحاء برغبة من فورد لإظهار دوره ودور مؤسسات دولية أخرى في التأسيس لحقبة الشرع، وتحضيره لاستلام قيادة سوريا. ربما أراد من وراء ذلك نسب الدور لنفسه، أو للولايات المتحدة الأميركية. وذلك في إطار محاولة للالتفاف على كل القوى الإقليمية والدولية التي تعتبر نفسها معنية بإنجاح التجربة السورية الجديدة، وفي ظل الانفتاح على سوريا. تبدو الصورة وكأن واشنطن تريد أن تتصدر المشهد وحدها، وأن يكون رفع العقوبات عن دمشق هو من ضمن السياق الأميركي وليس بناء على جهود دولية أو عربية أخرى بذلت في سبيل ذلك.
لا شك أن كلام فورد من شأنه أن يعزز منطق “المؤامرة” الدولية، التي حاول نظام بشار الأسد ترسيخها لدى الرأي العام السوري، العربي والدولي. بمعنى أن جهات دولية أميركية وبريطانية بالتحديد هي التي عملت على إثارة الثورة، ورعاية قوى مختلفة فيها، تمهيداً لتسليمها السلطة عندما يحين الوقت المناسب بالنسبة إليهم. هنا تجدر العودة سنوات إلى الوراء وإلى بدايات الثورة السورية، عندما اقترف فورد خطأ قاتلاً، إثر زيارته إلى حمص وحماه في العام 2011 وعقد لقاءات مع المتظاهرين والثوار. في حينها اتخذ نظام الأسد من زيارته ذريعة للقول إن التظاهرات تحصل بإشراف ورعاية من قبل الأميركيين.
موقف فورد في سوريا، له الكثير من المواقف التي تشبهه في لبنان لديبلوماسيين أميركيين. من أبرز هؤلاء كان السفير جيفري فيلتمان، والذي كان متحمساً إلى حدود بعيدة لقوى 14 آذار في فترة ثورة الأرز. في حينها، كان فيلتمان يقدم دعماً ووعوداً لهذه القوى في إطار مواجهة حزب الله، وصولاً إلى أحداث 7 أيار 2008 والتي اجتاح خلالها حزب الله لبيروت، بينما كانت الوعود الأميركية بمنع الحزب من ذلك، وتوفير كل الدعم اللازم لإنهاء مسألة سلاحه. أدى خطأ فيلتمان إلى تعزيز سطوة حزب الله أكثر على لبنان، في مقابل خسارة المشروع المضاد، وصولاً إلى حصول تقاطع أميركي إيراني في لبنان تُرجم أكثر فأكثر في سوريا والعراق طوال السنوات الفائتة، لا سيما لدى الوصول إلى الاتفاق النووي في العام 2015.
لا يمكن فصل موقف فورد، وكلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إطار مواصلة المزيد من الضغوط الأميركية على سوريا، لدفعها إلى السلام مع إسرائيل وتخويفها من الحرب الأهلية الداخلية أو من الانهيار. يتزامن ذلك مع حماسة أميركية للاهتمام بسوريا الجديدة القريبة من الغرب، بالإضافة إلى تدفق الكثير من المشاريع والاستثمارات إليها، في ظل الهجمة الكبرى على الاستثمار في المرافق والموانئ وفي القطاعات الزراعية والنفطية.
في موازاة هذه المواقف أو التسريبات، تشير مصادر متابعة إلى أن المسار السوري الأميركي لا يزال يحرز تقدماً، وفي ظل تشديد الأميركيين على إيجاد حلّ لمعضلة المقاتلين الأجانب. فبحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ”المدن”، هناك اتجاه إلى عدم إدخال أي مقاتل أجنبي في مؤسسات الدولة، كما أن الضباط الكبار الذين تم منحهم الجنسية السورية وعينوا بمناصب عالية سيحالون إلى التقاعد قريباً. كما سيتم إخراج الكثير من المقاتلين من سوريا إلى دول أخرى من بينها أفغانستان.
المدن
————————————–
من ألمانيا إلى سوريا: طريق عودة اللاجئين المحفوف بالأسئلة والمخاوف/ مصطفى الدباس
22.05.2025
في أعقاب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعادت الحكومة الألمانية تفعيل برامج العودة الطوعية، وشجعت السوريين الراغبين على الرجوع إلى بلادهم من خلال حوافز مالية ملموسة.
في واقعة طريفة تعكس تعقيدات ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد سقوط نظام بشار الأسد، طالب اللاجئ السوري عبد الهادي “ب” ، المدان سابقاً بالانتماء الى تنظيم “داعش” الإرهابي، الحكومةَ الألمانية بمبلغ 144 ألف يورو مقابل موافقته على العودة الطوعية إلى سوريا.
وكان حُكم على اللاجئ، البالغ 37 عاماً، بالسجن لخمس سنوات وثلاثة أشهر في عام 2018 لتورطه في تجنيد أنصار للتنظيم ومحاولة تحريض شخصين في سوريا على تنفيذ تفجير انتحاري، وعلى رغم صدور قرار بترحيله منذ ذلك الحين، تعذّر تنفيذ الإبعاد بسبب “الحرب الأهلية في سوريا” حسب التوصيف الرسمي.
برامج العودة الطوعية
في أعقاب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعادت الحكومة الألمانية تفعيل برامج العودة الطوعية، وشجعت السوريين الراغبين على الرجوع إلى بلادهم من خلال حوافز مالية ملموسة.
ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF، استفاد 464 لاجئاً سورياً من برنامج العودة الاتحادي بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 ونهاية نيسان/ أبريل 2025، وشمل البرنامج تغطية كاملة لتكاليف السفر، بالإضافة إلى منحة مالية تبلغ 1,000 يورو لكل شخص بالغ، و500 يورو لكل طفل، ومعونة سفر إضافية بقيمة 200 يورو للبالغين و100 يورو للقاصرين، فضلاً عن دعم صحي يصل إلى 2,000 يورو في الحالات الخاصة، وبحسب البرنامج يمكن أن تحصل الأسرة المكونة من والدين وطفلين على ما يصل إلى 4,000 يورو عند العودة.
إلى جانب البرنامج الاتحادي، واصلت بعض الولايات الألمانية تنفيذ برامجها الخاصة التي أطلقت منذ العام 2017، إذ استفاد منها 87 سورياً خلال العام 2024، و31 شخصاً إضافياً في الشهور الأولى من العام 2025، حسب شبكة التحرير الألمانية (RND). وعلى رغم استمرار الدعم المحلي، فضل معظم العائدين البرنامج الاتحادي الجديد الذي بدأ فعلياً منتصف شباط/ يناير 2025 ضمن مبادرة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، لكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، حذرت من أن العودة مرهونة بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل سوريا، وهو ما يتطلب دعماً دولياً لا يزال دون المستوى المطلوب.
آراء متباينة بين اللاجئين بشأن العودة
تفاوتت مواقف اللاجئين السوريين في ألمانيا حيال فكرة العودة إلى الوطن بعد سقوط نظام الأسد، بين من استقبل الخبر بفرح وحنين، ومن تحفّظ عليه بشكوك ومخاوف، وخرج الآلاف في مدن ألمانية كبرلين وإيسن وشتوتغارت في مظاهر احتفال عفوية عقب إعلان انهيار النظام، رافعين أعلام الثورة السورية وهتافات تنادي بالحرية والديمقراطية، من بين هؤلاء كان ريان الشبّل، أول رئيس بلدية سوري الأصل في ألمانيا، الذي عبر عن قناعته بأن “كثيرين من الناس سيعودون حتماً” إلى سوريا، واصفاً مشاعره عند سماع الخبر بالدموع والقشعريرة. كذلك عبّر المغني مزن محسن عن أمله ببناء نظام ديمقراطي جديد يضمن العدالة والمساواة، ما يفتح الباب لعودة حقيقية إلى وطن حر.
في المقابل، أبدى لاجئون آخرون تردّدهم حيال العودة السريعة، إذ عبّر أحد اللاجئين العلويين عن قلقه من الانتقام الجماعي الذي قد يطاول طائفته، مؤكداً أن سقوط الأسد لا يجب أن يعني محاسبة الطائفة بكاملها، تعليقاً على المجازر التي حصلت في مدن الساحل السوري بحق العلويين.
أما السوريون الذين “اندمجوا بعمق” في المجتمع الألماني حسب تعبير الصحف الألمانية، فكانت لهم هواجس من نوع آخر لأنهم بنوا حياة مستقرة في ألمانيا، حيث يدرس نحو 200 ألف طفل سوري في المدارس الألمانية، ويوجد حوالي 50 ألف شاب في برامج التدريب المهني، بينما دخل كثر من البالغين سوق العمل واستقروا وظيفياً، وبالنسبة الى هؤلاء، تعني العودة التخلي عن كل ما تم تحقيقه والبدء من جديد في بلد ما زال غير مستقر.
وثقت منظمة “برو أزول” الحقوقية الألمانية حالة القلق هذه، مشيرة إلى أنها تلقت عدداً هائلًا من الاستفسارات فور سقوط النظام من لاجئين يخشون الترحيل أو فقدان الحماية القانونية التي يتمتعون بها. وأكد المتحدث باسم المنظمة، طارق العلاو، أن “العودة في ظل هذه الظروف مخاطرة بل ومهلكة للحياة”، معتبراً الدعوات السياسية لعودة اللاجئين الآن غير واقعية وغير إنسانية.
شهدت أروقة السياسة الألمانية نقاشات موسعة بشأن إعادة صياغة سياسة اللجوء تجاه السوريين من دون إصدار قانون جديد صريح حتى تموز/ يوليو 2025، إلا أن اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد بين الحزبين “الديمقراطي المسيحي” و”الاشتراكي الديمقراطي” رسم ملامح لنهج أكثر تشدداً، يتضمن البدء بترحيل السوريين المدانين بجرائم أو المصنفين كمصدر تهديد أمني، على أن يدرس لاحقاً توسيع الترحيل لفئات أوسع إذا استقرت الأوضاع في سوريا.
في هذا السياق، بدأت الجهات الأمنية حصر أسماء الأشخاص المعنيين، فيما صرحت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر بأن التشريعات الخاصة بترحيل “الأجانب الخطرين” تم تشديدها استناداً إلى تعديلات أقرتها حكومة المستشار الألماني السابق أولاف شولتس أواخر العام 2023 عقب حادثة طعن إرهابية في مدينة زولينغن، وتسمح هذه التعديلات بتسريع الترحيل وسحب بعض صلاحيات المنع من حكومات الولايات.
وفي نيسان/ أبريل 2025، زارت الوزيرة فيزر دمشق برفقة نظيرها النمساوي لبحث إمكانية إعادة الجناة مع السلطات السورية الجديدة، مؤكدة دعم ألمانيا لانتقال ديمقراطي في سوريا، مع مطالبة القيادة الجديدة بالتعاون في استعادة المطلوبين أمنياً.
بالتوازي، طرحت وزارة الداخلية الاتحادية مبادرة جديدة تسمح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم لفترة قصيرة من دون فقدان وضع اللجوء، بهدف تفقد أوضاعهم الشخصية تمهيداً لعودة دائمة. وبحسب الخطة، يحق للاجئ التقدم بطلب لرحلة استطلاعية إلى سوريا لمدة لا تتجاوز الأربعة أسابيع، أو رحلتين مدة كل منها أسبوعان، على أن تدار هذه الزيارات تحت إشراف سلطات الأجانب وبتنسيق مع BAMF. وقد رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذه الخطوة ووصفتها بـ”المشجعة”، بينما انتقدتها ولاية بافاريا ووصفتها بأنها قد تُستغل كـ”رحلات عطلة مقنّعة”.
وعلى رغم صرامة الخطاب السياسي، فإن ألمانيا لم تنفذ حتى الآن أي ترحيلات قسرية، واستمر الوضع القانوني لغالبية السوريين من دون تغييرات فورية.
زيارات مؤقتة إلى سوريا تثير الجدل وتضع الحماية تحت المراجعة
على رغم أن القانون الألماني يمنع اللاجئين من العودة إلى بلادهم الأصلية من دون مبررات استثنائية، كشفت تقارير رسمية عن قيام مئات السوريين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الألمانية بزيارات مؤقتة إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وكشفت تقارير إعلامية، أنه خلال الفترة بين 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 و31 آذار/ مارس 2025، فتح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF إجراءات مراجعة بحق 2,157 لاجئاً من جنسيات مختلفة عادوا مؤقتاً إلى أوطانهم، بينهم 734 حالة لسوريين زاروا سوريا ثم عادوا إلى ألمانيا، وتعد مثل هذه الزيارات، إذا لم يكن متفقاً عليها، انتهاكاً لشروط الحماية، ما يستوجب إعادة فتح ملف إسقاط صفة اللجوء، إلا أن جميع هذه الملفات وضعت حالياً تحت التعليق المؤقت بسبب استمرار مراجعة الوضع الأمني في سوريا.
في هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية أن القانون أصبح أكثر صرامة تجاه من يستغل وضعه كلاجئ للسفر إلى بلد يدّعي أنه فر منه خوفاً من الاضطهاد، ومع ذلك، لم يتخذ بعد أي قرار نهائي بسحب الحماية من هؤلاء الأشخاص، ما دام لم يعلن رسمياً أن سوريا أصبحت بلداً آمناً.
اللاجئون الجدد وحظوظ الأقليات المهدّدة
لم تتوقف موجات اللجوء إلى ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد، بل استمرت بوتيرة مرتفعة، مع تسجيل 76,800 طلب لجوء جديد من سوريين في عام 2024، وقرابة 9,900 طلب إضافي خلال الربع الأول من عام 2025، بحسب بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ويعكس هذا الاستمرار واقع أن تبدُّل السلطة لم ينهِ دوافع اللجوء، بل خلق في بعض الحالات دوافع جديدة، خصوصاً لفئات كانت موالية للنظام السابق أو تنتمي إلى أقليات مهدّدة بالانتقام.
واتسمت السياسة الألمانية تجاه هؤلاء القادمين الجدد بالحذر، مع قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء BAMF تعليق البت في طلبات اللجوء السورية مؤقتاً، بانتظار إعادة تقييم ما إذا كانت سوريا أصبحت بلداً “آمنًا. في هذه الأثناء، تبقى ملفاتهم “معلّقة”، من دون ترحيل قسري، ولكن أيضاً من دون ضمان سريع للحصول على الحماية، إلا أن المكتب أعاد تفعيل البت بطلبات اللجوء الجديدة أواخر الشهر الماضي.
في المقابل، سلطت التطورات الميدانية في سوريا الضوء على الخطر الحقيقي الذي تواجهه بعض الأقليات، لا سيما بعد المجازر التي ارتكبتها جماعات إسلامية متطرفة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين، والتي وصفها مراقبون بأنها “حملة تطهير عرقي”.
وأثارت هذه الأحداث قلقاً كبيراً داخل ألمانيا، التي أعادت تأكيد التزامها بتوفير الحماية للأشخاص المهددين بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجنسي، مثل العلويين، المسيحيين، الدروز، والمثليين، إذ أوضحت السلطات الألمانية أن هؤلاء ما زالوا مشمولين بحق اللجوء أو الحماية الفرعية، بموجب “اتفاقية جنيف” و”الدستور الألماني”، شرط إثبات خطر حقيقي يهدد حياتهم. وأشارت التقارير إلى أن حوالي 321 ألف سوري حصلوا على صفة لاجئ وفق المعايير الدولية حتى أواخر العام 2024، بينهم 5,000 فقط صُنِّفوا كلاجئين سياسيين لأسباب فردية.
سوريو المهجر الألمان
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية، ما يعكس اندماجهم المتزايد في المجتمع واستيفاءهم شروط التجنيس بعد مضي نحو 6 إلى 8 سنوات على موجة اللجوء الكبرى في 2015–2016.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، حصل 75,500 سوري على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة قدرها 56 في المئة مقارنة بعام 2022، ليصبحوا الفئة الأجنبية الأكبر من حيث معدل التجنيس.
وانعكس هذا التحول على إحصاءات الجالية السورية، إذ بدأ العدد المسجل للسوريين كأجانب في الانخفاض تدريجياً، على رغم استمرار تدفق لاجئين جدد. وبلغ عدد السوريين المسجلين كأجانب بحلول آذار/ مارس 2025، نحو 968,900، بانخفاض عن الشهر السابق نتيجة انتقال المجنسين إلى خانة “المواطنين الألمان”. وعلى الرغم من احتفاظ كثر من هؤلاء بجنسيتهم السورية، إلا أن حملهم الجواز الألماني يعني خروجهم من منظومة اللجوء والإقامة، وامتلاكهم حرية السفر والإقامة في سوريا من دون تبعات قانونية.
وتقدّر أعداد المجنسين السوريين منذ 2015 بعشرات الآلاف، وباتوا يشكلون شريحة جديدة تعرف إعلامياً بـ”سوريي المهجر الألمان“، ويحملون هوية مزدوجة ثقافياً. والجدير بالذكر أن 18 في المئة من السوريين ذوي الخلفية المهاجرة في ألمانيا ولدوا فيها، ما يشير إلى نشوء جيل جديد متجذر في المجتمع الألماني، يصعب تصوّره خارج هذا السياق الاجتماعي والثقافي.
– صحافي سوري مقيم في برلين
درج
—————————–
العقل الأمني الروسي.. من الشيشان إلى سوريا فإفريقيا/ مالك الحافظ
2025.05.23
بُعيد تشكيل السلطة الانتقالية في سوريا، توالت المؤشرات على أن النفوذ الروسي في البلاد لم يعد مكتملاً كما كان يُقدّم في سنوات ما قبل السقوط.
فمع انفتاح بعض العواصم الغربية على السلطة الجديدة، بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي برفع العقوبات عن سوريا، وتزايد الحضور الأميركي في الملف السوري خلال المرحلة الجديدة، بدأت تظهر على السطح تساؤلات جادة تتعلق بمصير الوجود الروسي في سوريا.
يبقى السؤال الأهم متعلقاً بطبيعة الوجود الروسي، إذ لا يُفهم الحضور الروسي في سوريا، ولا في غيرها من الساحات الخارجية، إلا عبر تفكيك البنية العميقة التي تُنتج هذا الحضور المتمثل من خلال العقل الأمني الروسي، بوصفه جوهر الدولة الروسية المعاصرة ومنهجيتها في فرض الهيمنة.
مع صعود فلاديمير بوتين إلى السلطة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، أخذت الدولة الروسية تنزلق تدريجياً من فكرة “استعادة المركز” إلى فكرة “إعادة إنتاج السيطرة”، ليس عبر الدولة الديمقراطية أو اقتصاد السوق، إنما عبر نموذج الدولة–الجهاز التي تحكم من خلال منظومات أمنية معقدة، وقوى موازية، ومؤسسات هجينة. الحرب الثانية في الشيشان عام 2000 كانت التمرين الأول لهذا النمط حيث تم سحق التمرد بالعنف المفرط، ثم تثبيت نخبة محلية موالية تحت قيادة أمنية، ثم دمج النصر السياسي بالاستثمار الاقتصادي، ليس لصالح الدولة إنما لصالح شبكات السلطة المتداخلة.
هذه التجربة الشيشانية تم تصديرها لاحقاً إلى مساحات خارجية عبر ما يُعرف اليوم بـ”العقل الأمني التوسعي”، والذي ينتج السياسة الخارجية من خلال إعادة تشكيل البنى الأمنية للدول المستهدفة، أو الضعيفة، أو المتداعية. وتُعد سوريا أبرز هذه النماذج، بعد تدخل موسكو العسكري المباشر أواخر عام 2015، والذي كان تأسيساً لنموذج نفوذ أمني لا يشبه الاحتلال، ولا يشبه التحالف، إنما ينتمي إلى صنف ثالث، غائم التوصيف لكن بالغ الفاعلية.
في صلب هذا النموذج يكمن الاستخدام المنهجي للجماعات العسكرية غير الرسمية، من شركات المرتزقة إلى شبكات رجال الأعمال المتصلين بالمؤسسة العسكرية.
تُعد شركة “فاغنر” التعبير الأبرز عن هذا النمط، لكنها ليست الوحيدة ولا الأهم بالضرورة. فالأمر يتركز عند البنية، وذلك أن تتحول أدوات العنف المنفلت إلى وسائل لإنتاج النظام، وأن يصبح الخارج الأمني بديلاً عن الداخل السيادي.
في سوريا، مارست موسكو هذا النموذج عبر نشر وحدات غير نظامية في محاور عدة، بينها البادية، ومواقع السيطرة على الموارد، وبعض مفاصل الساحل السوري. لم تكن هذه الوحدات مجرد قوة رديفة، إنما شكلت خطوط تماس اقتصادية وسياسية مع المجتمع المحلي، وأعادت ترتيب الولاءات من خلال الرواتب، والحماية، والامتيازات.
وقد أتاح هذا الأسلوب إخراج النفوذ الروسي من رقابة نظام الأسد نفسه، وتحويله إلى نمط سيطرة مباشر، وإن كان مموهاً بوصفه “دعماً حليفاً”.
مع انتقال السلطة في دمشق إلى قيادة انتقالية، بدأت تظهر فجوات في هذا النموذج. فروسيا التي بنت وجودها على توافق ضمني مع نظام الأسد، تجد نفسها اليوم أمام سلطة لا تكنّ لها العداء صراحة، لكنها أيضاً لا تمنحها صكّ السيادة كما فعل بشار الأسد.
هذا النموذج لم يُطبق في سوريا فقط، لقد جرى تعميمه على نطاق واسع في إفريقيا، خصوصاً في مالي، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى. هناك أيضاً تظهر البنية ذاتها؛ مرتزقة روس يوفرون الحماية للنخب المحلية مقابل الامتيازات في الذهب واليورانيوم، وتُدار الدولة من خلال شبكة أمنية–استخبارية بديلة عن الجهاز الإداري. ولا تمر الصفقات عبر البرلمانات، إنما من خلال وسطاء، ومقاتلين، ومستشارين غير رسميين.
بهذا المعنى، يتحول العقل الأمني الروسي إلى نمط عالمي من “الدولة البديلة”. دولة لا تعترف بالحدود، ولا بالسيادة، إنما تمارس السلطة من خلال أدوات لا تنتمي للدولة نفسها، لكنها تُنتج لها القوة والنفوذ.
بعد سقوط نظام الأسد، وتشكل سلطة انتقالية، ومع تراجع القدرة الروسية على تقديم ضمانات أمنية واقتصادية واضحة، يدخل النموذج الروسي في سوريا مرحلة اختبار بنيوي. فليس من المؤكد أن تستطيع موسكو الحفاظ على أدوات نفوذها دون إعادة تعريف علاقتها بالسلطة الجديدة، ولا أن تستمر في نشر أدوات السيطرة غير الرسمية في ظل رغبة أميركية وأوروبية معلنة – وإن لم تُصغ بصيغة المواجهة – في تحجيم دور روسيا في مرحلة إعادة التشكل.
بعبارة أدق فإن قدرة روسيا على البقاء لاعباً في سوريا لم تعد ترتبط فقط بعدد الجنود أو القواعد، بل بمدى صلاحية نموذجها الأمني في ظرف سياسي جديد.
تلفزيون سوريا
——————————–
محللون: هذه دلالات ودوافع الهجوم على قاعدة حميميم الروسية بسوريا/ أحمد العكلة
22/5/2025
سوريا – شن مسلحان هجوما على قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل جنديين، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي سوري وناشط محلي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما، أنه تم أيضا قتل المسلحين اللذين نفذا الهجوم أول أمس الثلاثاء.
وقال المسؤول السوري إنه لم يتضح ما إذا كان الشخصان اللذان قتلا في القاعدة جنديين روسيين أم متعاقدين سوريين. ووفقا للوكالة، لم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق. كما لم تصدر الحكومة السورية أي بيان رسمي حول الحادث.
اعتداء على مدنيين
أكد رامي الشاعر، المحلل السياسي المقرب من دوائر صناعة القرار في روسيا، أن ما حدث في القاعدة الروسية مؤخرًا لا يجب وصفه بـ”هجوم”، بل بـ”اعتداء إرهابي”، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء استهدف قاعدة يوجد فيها عدد كبير من العائلات السورية، معظمهم من المدنيين الذين لجؤوا إليها هربًا من التوترات الأمنية في الساحل السوري.
وأضاف الشاعر، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، أن السلطات السورية تبذل جهودًا كبيرة لمعرفة الجهة التي تقف وراء تلك الأحداث، مؤكدا أن هناك تحقيقات جارية لمحاسبة كل من تورط في إراقة الدماء، خصوصًا بين المدنيين.
وفي السياق، أوضح أن الرئيس السوري أصدر مرسومًا قبل أيام لتمديد عمل لجنة التحقيق شهرين إضافيين، وهو ما يعكس -بحسب الشاعر- اهتمامًا مباشرًا من الرئيس بالقضية ومتابعته الدقيقة لسير التحقيقات.
وتابع “لا أستبعد أن يكون هذا الاعتداء نتيجة استياء بعض الأطراف من عمل لجنة التحقيق، أو حتى من قرار تشكيلها أساسًا، خاصة بعد أن توصلت اللجنة إلى نتائج أولية تحدد بشكل واضح بعض المسؤولين عن أحداث الساحل السوري”. وشدد على أن الحكومة السورية الحالية لن تتهاون في محاسبة المتورطين.
كما أشار الشاعر إلى أن “العملية الإرهابية” الأخيرة قد تكون محاولة لإرباك جهود التحقيق، لكنها لن تنجح في ثني القيادة السورية عن استكمال المسار القضائي ومحاسبة المتورطين، سواء في أحداث الساحل أو في الاعتداء الأخير.
موسكو ودمشق
وفي ما يتعلق بالعلاقات بين موسكو ودمشق، أكد الشاعر أن هذه العمليات لن تؤثر بأي شكل على متانة العلاقات الروسية السورية، التي وصفها بـ”الإستراتيجية”. وأضاف أن روسيا تواصل دعمها للحكومة السورية في مختلف المجالات، لا سيما في الملفات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتجاوز تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فاقمت من معاناة الشعب السوري.
وبدأ الهجوم، وفق ما أفاد شاهد عيان يقيم في محيط القاعدة لوكالة الصحافة الفرنسية من دون الكشف عن هويته، “عند الساعة السابعة صباح الثلاثاء واستمر لساعة، سمعنا خلالها دوي إطلاق رصاص وقذائف مع تحليق مسيرات في الأجواء”. وقال إن سكان المنطقة كانوا قد “رصدوا انتشارا لعناصر الأمن العام في محيط القاعدة منذ أيام”.
وكشف الأكاديمي والباحث المتخصص في الشأن الروسي محمود الحمزة، في تصريح للجزيرة نت، أن وضع القاعدة الجوية الروسية في حميميم يشهد حالة من عدم الاستقرار والغموض، مشيرًا إلى أن مصيرها لا يزال غير محسوم مثل قاعدة طرطوس.
وأكد الحمزة أن هناك قضايا عالقة بين موسكو ودمشق لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، خاصة في ظل الحكومة السورية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة السورية الحالية قدّمت مجموعة من الطلبات إلى موسكو، إلا أن الأخيرة لم ترد عليها حتى الآن، وفي مقدمتها ما يتعلق بمصير بشار الأسد، الذي وصفه بـ”المجرم الهارب”، والأموال التي نهبها، بالإضافة إلى مصير آلاف الضباط التابعين للنظام السابق الذين استقروا في روسيا. واعتبر أن هذه الملفات الشائكة تعكس توترًا حقيقيا في العلاقات بين الجانبين.
دوافع وأسباب
وفي سياق متصل، أشار الحمزة إلى أن القاعدة الروسية حميميم، رغم عدم التعرض لها خلال انتصار الثورة السورية، استقبلت في الآونة الأخيرة عددًا من فلول النظام الهاربين عقب أحداث الساحل الأخيرة، مما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السورية.
ووصف الهجوم الأخير على قاعدة حميميم بأنه تطور خطير، خاصة وأنه وقع في منطقة ذات أغلبية علوية، مما يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. وأفاد بأن التقارير تشير إلى أن المهاجمين ينتمون لجماعات أوزبكية متشددة موجودة في سوريا.
وأضاف الحمزة أن من المرجح أن الهجوم تم دون علم أو موافقة الحكومة السورية الجديدة، التي لا مصلحة لها في خلق الفوضى أو التوتر داخل البلاد، مرجحًا أن يكون الحادث ناتجًا عن تحركات فردية لمتشددين يحملون عداءً أيديولوجيًا تجاه روسيا.
وفي إطار تفسير دوافع هذا العداء، أشار إلى أن “المتشددين الإسلاميين” يرون في روسيا عدوًا إستراتيجيًا، ليس فقط في سوريا بل في عدة مناطق أخرى. وربط الهجوم بتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون روس كبار، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الدوما، تحدثوا فيها عن “إبادة جماعية” للعلويين والمسيحيين، وهو ما وصفه الحمزة بأنه “تصريحات غير دقيقة وغير واقعية”.
وانتقد الحمزة الإعلام الروسي وبعض المسؤولين الذين ينخرطون في مواقف وتصريحات تؤجج الأوضاع وتزيد من تعقيد المشهد، مؤكدًا أنه لا وجود لعمليات تصفية جماعية كما يُروّج، وإنما هناك مواجهة بين الدولة وجماعات مسلحة خارجة عن القانون.
تواجه روسيا معادلة جديدة في كيفية الحفاظ على مكاسبها الإستراتيجية والعسكرية والاقتصادية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ويتساءل مراقبون عمّا إذا كانت موسكو ستعيد تموضعها لدعم النظام الجديد، أم أن نفوذها مرشح للتراجع لصالح قوى دولية وإقليمية أخرى.
العميد والخبير العسكري محمد الخالد يؤكد أن هناك عدة دوافع لهذا الهجوم، منها أن يكون بفعل فصائل تريد الانتقام من الجنود الروس المسؤولين عن مئات المجازر بحق السوريين لمساندة بشار الأسد، وكذلك حمايته في روسيا بعد سقوطه.
وأضاف، في حديث للجزيرة نت، أن السبب قد يكون أيضا حماية القاعدة الروسية لقادة عسكريين في جيش الأسد المخلوع والتخوف من قيام روسيا بدعمهم عسكريا لتشكيل تمرد عسكري كما حصل في مارس/آذار الماضي، لذلك هناك نوع من إبقاء القاعدة الروسية تحت الضغط بهدف رفع سقف التفاوض، وفق رأيه.
المصدر : الجزيرة
——————————–
“اندبندنت عربية” تكشف هوية المنظمة البريطانية التي دربت الشرع سياسيا/ عيسى النهاري
تدعى “إنتر ميديت” ومؤسسها هو مستشار الأمن القومي الحالي جوناثان باول
الأربعاء 21 مايو 2025
كشفت مصادر مطلعة لـ”اندبندنت عربية” عن أن المنظمة البريطانية التي قدمت الدعم والتأهيل السياسي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، هي منظمة “إنتر ميديت” ومقرها لندن. وكان السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد أشار في وقت سابق هذا الشهر إلى عمله مع المنظمة لتقديم المشورة للشرع قبل نحو عامين من إسقاطه نظام بشار الأسد.
مؤسسها مستشار الأمن القومي البريطاني الحالي
“إنتر ميديت” هي منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في الوساطة والتفاوض في النزاعات المعقدة وفق موقعها الرسمي الذي اطلعت عليه “اندبندنت عربية”، وأسسها عام 2011 جوناثان باول الذي شغل سابقاً منصب كبير الموظفين لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وغادر جوناثان باول المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 بعدما عيّنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مستشاراً للأمن القومي، إذ يشرف على تنسيق ملفات السياسة الخارجية والأمن والدفاع والعلاقات الأوروبية والشؤون الاقتصادية الدولية من مقر رئاسة الوزراء في “10 داونينغ ستريت”.
وشارك في تأسيس “إنتر ميديت” أيضاً الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث، المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ حتى يوليو (تموز) عام 2024.
متخصصة في عقد الحوارات السرية
وتعرّف “إنتر ميديت” نفسها بأنها منظمة تركز على حل النزاعات الأكثر خطورة وتعقيداً والتي يصعب على منظمات أخرى العمل فيها. وبحسب موقعها، “تضم المؤسسة نخبة من أبرز خبراء التفاوض والحوار في العالم، وتعمل بفريق صغير ومرن يسعى إلى ملء الفراغ في مشهد حل النزاعات”.
وتؤكد المنظمة البريطانية أنها تسعى إلى إطلاق “حوارات مجدية وسرية”، بخاصة في الصراعات التي تفتقر إلى قنوات فاعلة، مما يبرر غموض دورها في سوريا. كما يفيد موقعها الرسمي بأنها “تعمل كمنصة تواصل لأطراف النزاعات حول العالم. وتعتمد على خبرة ومعرفة كبار السياسيين والدبلوماسيين والخبراء، وتستجيب لحاجات الأطراف من خلال مشاركة تجاربها في عمليات السلام السابقة”.
مديرة تنفيذية جديدة أصولها فلسطينية – يهودية
وبالتزامن مع مغادرة باول، أعلن مجلس أمناء المنظمة تعيين كلير حجاج مديرة تنفيذية جديدة اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2024، وبحسب موقع المنظمة، فإن حجاج من أصول فلسطينية ويهودية وانضمت إلى المنظمة عام 2018، حيث عملت كمديرة للسياسات ثم نائبة للرئيس التنفيذي، وكانت مسؤولة عن قيادة الاستراتيجية والإشراف على أبرز مشاريع في مناطق متعددة من العالم، من هايتي إلى غزة.
وبدأت حجاج مسيرتها المهنية في مجال حل النزاعات والتفاوض ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2002، حيث عملت مع لجنة مكافحة الإرهاب. وعلى مدى أكثر من 20 عاماً، أسهمت في مفاوضات إنسانية وسياسية وأمنية في مناطق النزاع في العالم، بما في ذلك لبنان وكوسوفو والعراق وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وباكستان. وعملت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق في ذروة التمرد بعد الغزو الأميركي.
ويشير موقع “إنتر ميديت” أنها تسعى إلى الاستفادة من موارد المنظمات الكبرى، مثل الحكومات والمؤسسات الدولية التي تنفق مليارات الدولارات سنوياً للتعامل مع آثار النزاعات، عبر جهود حفظ السلام والتدخلات الإنسانية.
روبرت فورد يكشف عن كواليس الدور البريطاني
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد خلال جلسة لـ”مجلس العلاقات الدولية في بالتيمور” عن أن منظمة بريطانية متخصصة في حل النزاعات، لم يسمِّها حينها، كانت وراء مبادرة لدمج أحمد الشرع في الحياة السياسية، بعد أعوام من انخراطه في جماعات مصنفة إرهابياً على المستوى الدولي.
وأكد السفير السابق أنه كان متردداً في البداية في الانضمام إلى المبادرة ولقاء الشرع، لكنه وافق لاحقاً على تقديم المساعدة بدعوة من المنظمة البريطانية.
مدينة حماة السورية
وكان فورد أول دبلوماسي غربي يزور مدينة حماة السورية في بدايات الثورة عام 2011، في خطوة أثارت غضب النظام السوري، مما دفع واشنطن لاحقاً إلى سحبه لأسباب أمنية، وهو اليوم من أبرز الأصوات الأميركية في الشأن السوري، ويعمل باحثاً في عدد من مراكز الفكر والسياسات.
من جانبها وصفت الرئاسة السورية تصريحات فورد حول لقاءاته مع الرئيس الشرع بأنها “غير صحيحة” وأن الجلسات التي حضرها كانت مخصصة لتجربة إدلب مع وفود أجنبية زائرة، مشيرة إلى أن الدبلوماسي المتقاعد كان ضمن وفد تابع لمنظمة بريطانية للدراسات والأبحاث.
وحاولت “اندبندنت عربية” التواصل مع منظمة “إنتر ميديت”، لكنها لم تتلقَّ رداً.
دور المنظمات غير الحكومية
وعن دور المنظمات غير الحكومية، أشار الباحث في الشأن السوري تشارلز ليستر إلى أن منظمات عدة غير حكومية مرموقة شاركت خلال الأعوام الأخيرة في حوارات مع الأطراف السورية، ولا يقتصر ذلك على “هيئة تحرير الشام” آنذاك بقيادة الشرع، بل حتى مع نظام الأسد و”قوات سوريا الديمقراطية”، بهدف فهم أجنداتهم السياسية وإشراكهم في المفاوضات.
أضاف، “بصفتي شخصاً قضى سنوات طويلة منضوياً بعمق في إدارة مثل هذه الحوارات في الماضي، أستطيع أن أؤكد بثقة أن هذه العمليات تقوم بدور بالغ الأهمية في تمهيد الطريق نحو تفاهم أفضل، بعيداً من انعدام الثقة والعداء، وفي نهاية المطاف بناء الثقة اللازمة لتحقيق تقدم دبلوماسي حقيقي”.
————————————
من معجم القذائف اللفظية: إبداع لغوي شعبي في زمن الثورة السورية/ موسى الحالول
2025.05.22
ليس غريبًا أن تصاحبَ معاركَ الميدان بين المتحاربين قذائفُ لفظيةٌ موازيةٌ. وقد كانت القبائل العربية قديمًا تحتفل إذا وُلِدَ لها شاعرٌ كاحتفائها ببروز فارسٍ فيها، لأن هذا يُبارِز عنها بسيفه، وذاك يُطاعِن عنها بلسانه. والسوريون اليوم ليسوا استثناءً. لكني لن أركز في مقالي هذا على مساجلات النخبة من أدباء ومعلقين سياسيين، بل على المصطلحات الشعبية التي راجت في صفوف المعارضة السورية لترذيل نظام الأسد ورموزه ومُواليه منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011 إلى ما بعد سقوط هذا النظام، ذلك لأن هذه المصطلحات تعبر عن الضمير الجمعي السوري المناهض لنظام الأسد.
أحاول في هذا المقال أن أستقصي مظاهر الإبداع اللغوي الشعبي الذي رافق الثورة السورية، وذلك برصدٍ وتحليلٍ لسبعةٍ من المسكوكات اللفظية التي اجترحها السوريون في خضم الصراع، ولا سيما في صفوف المعارضة الشعبية، لتسمية الظواهر والأشخاص والسلوكيات المرتبطة بنظام الأسد وممارسات أزلامه. لا يهدف المقال إلى حصر كل ما أبدعه السوريون من مفردات ومصطلحات، بل إلى تقديم قراءة دلالية وصرفية موجزة لبعض هذه القذائف اللفظية التي كشفت عن قدرة السوريين على تحويل الألم والاضطهاد إلى مادة لغوية غنية، وكيف يمكن أن يكون للكلمة دورٌ مُوازٍ للرصاصة في سياق المقاومة الرمزية. وبين التحليل المعجمي والسخرية السياسية، أسعى إلى تسليط الضوء على تفاعل اللغة مع العنف والهوية والذاكرة في لحظة مفصلية من التاريخ السوري الحديث.
اللافت للانتباه فيما سكَّه المعارضون السوريون هو أن مصطلحاتهم تتسم بالجدة والطرافة أو حتى الفكاهة، وهذا راجعٌ، فيما أظن، إلى كونها عاميةً، ولذلك فهي عفويةٌ نابعةٌ من القلب لا تَكَلُّف فيها، وتدل على خيال شعبي خِصب، في حين نجد أن المصطلحات التي روَّج لها النظام وموالوه كانت باهتةً تفتقر إلى الأصالة والإبداع. فأغلب ما وَصَمَ به نظامُ الأسد معارضيه كان كليشيهاتٍ ممجوجةً مثل إرهابيين، طائفيين، تكفيريين، مندسين، عملاء، مأجورين، مرتزقة، إلخ. لعل الاستثناء الوحيد الذي جادت به قريحة الموالين وفيه شيءٌ من الإبداع والطرافة هو مصطلح العَراعرة (أي، أتباع الشيخ المعارض عدنان العرعور الذي كان يهاجم النظام من مقر إقامته في الرياض).
الشَّبِّيحة
حين شاعت مفردةُ “الشَّبِّيح،” كانت تعني حرفيًا الشخصَ الذي يركب سيارة “شَبَح،” وهو اسم شعبي لنوع من أنواع المرسيدس شاع في سوريا ربما منذ ثمانينات القرن الماضي. وقد كان الشبِّيحةُ (جمع “شبِّيح”) يشتغلون حينذاك في تهريب المخدرات والسجائر والسلاح والمشروبات الكحولية بين لبنان وسوريا والعراق. تميَّز هؤلاء بضخامة أجسادهم وعضلاتهم المفتولة ولِحاهم الطويلة ورؤوسهم الحليقة وقلة عقولهم وطاعتهم العمياء لقائدهم.
لكن طرأ على مفردة “الشبِّيح” تطور دلالي بعد انطلاق الثورة السورية في عام 2011. فقد انتقلت المفردة من حقل الجرائم الاقتصادية إلى حقل الجرائم الإنسانية. وقد شَكَّل الشبِّيحةُ في هذه المرحلة قواتٍ رديفةً لقوات بشار الأسد، وكان رامي مخلوف، ابنُ خاله، الممولَ الأساسيَّ لهذه القوات التي ولغت في دم الشعب السوري الثائر. ومن هذه المفردة اجترحَ السوريون فعلاً ومصدرًا (شَبَّح، يُشبِّح، تَشْبيحًا). في البداية، كان هذا الفعل يعني أن يقاتل الشبيحُ أيَّ معارض للأسد أو أن يقتله إن استطاع (وقد فعلَ الشبيحةُ بالمواطنين ما فعلوا). لكنه اليوم بات يعني أن يمارسَ أيُّ مُسْتَزلِمٍ العنفَ الجسديَّ واللفظيَّ على فئة مستضعفة. ولذلك ظهر منذ مدة قريبة مصطلح “الشبيحة الجُدُد” (على شاكلة المحافظين الجدد في زمن جورج بُش الابن)، ويُقصَد بهؤلاء الموالونَ لحكومة الرئيس أحمد الشرع. وإضافة صفة “الجُدُد” إلى “الشبيحة” تشير إلى إعادة تدوير لفظي لمصطلح قديم وبداية هجوم سياسي مضاد يدل على مرحلة جديدة في دائرة الصراع المستمر حتى الآن.
وبما أن الشيء بالشيء يُذكر، فدعونا نتوقف عند مصطلحٍ ذي صلة بهذا السياق اللغوي-السياسي، وهو “الشَّبْح”. وهذا مصطلح عرفته المعاجمُ العربيةُ (أي، مَدُّك الشيءَ بين أوتادٍ ليجفَّ) كما ورد في “كتاب العين.” لكن ليس لنظام الأسدَيْنِ فضلٌ إلا في إحياء هذا المصدر وتوسعة دلالته، إذ بات يعني تعليق السجين من رجليه من السقف وتعذيبه بالسياط وغيرها. وهكذا أصبح فعلُ “الشَبْح” فعلًا سوريًا محفوظةً حقوقُه لآل الأسد وزبانيتهم. أي، أنهم هم الذين أخرجوا هذا المصطلح بدلالته الجديدة وليس مناوِئوهم. لكن هؤلاء هم الذين أشاعوه في أحاديثهم الإعلامية ومذكراتهم بعد خروجهم أحياءً من مسالخ الأسد البشرية، وذلك لفضح أساليب التعذيب الوحشية التي اتبعها النظام مع معارضيه.
المِنْحِبَكجي
المِنْحِبَكجي، اصطلاحًا، هو الموالي الأعمى لبشار الأسد. ويعود أصل الكلمة إلى شعار “مِنْحِبَّك” (أي، نُحِبُّك) الذي انتشر على لوحات إعلانية تحمل صورة بشار الأسد بعد أن ورث “العرشَ الجُملوكيَّ” من أبيه “الخالد” حافظ الأسد في عام 2000.
ولا بد من تفكيك كلمة “مِنْحِبَكجي” للوقوف على أسرار الإبداع (أو العَسْف، إن شئتم) في اشتقاقها الصرفي. فالميمُ بادئةٌ تُضافُ إلى الفعل المضارع في بعض العامِّيات السورية، وقد تفيد التوكيد؛ أما الفعل “نْحِبَّك” العامي فيحتوي، كنظيره الفصيح، على الفعل والفاعل (وهو هنا ضمير مستتر تقديره “نحن”) والمفعول به (كاف الخطاب). أما “جي” فهي لاحقة عامية مستعارة من اللغة التركية، تُضاف إلى الاسم للدلالة على مهنة أو صفة لازمة في المُشار إليه كما في كلمة “قهوجي” أو “نِسْوَنجي،” على سبيل المثال. لكن من الناحية الصرفية، تنطوي كلمة “مِنْحِبَّكجي” على تنافر صَرفي وعددي: فهي تجمع الجمعَ والمفردَ معًا (بخلاف النحت الكلاسيكي لمصطلح “اللاأدْرِيِّ”). فَنُونُ المضارعةُ في “نْحِبَّك” تدل على جمعٍ (نحن)، في حين أن اللاحقة التركية “جي” تدل أصلًا على مفردٍ (هو). ترى، هل يدل هذا التنافر الصرفي أو العَسف الاشتقاقي على طبيعة هذه الكائنات الغريبة المُنَفِّرة؟ على أي حالٍ، ولكي لأسهم مع أهلي السوريين في إثراء خطاب المعارضة، اجترحتُ قبل عدة سنوات لهذا المسكوك اللفظي العجيب ترجمةً إنجليزيةً لا تقل عن أصلها العربي عَجبًا: we-love-you-ist.
التعفيش
شاع هذا المصطلحُ بعد موجة النزوح السوري وتهجير السكان من مساكنهم في المدن والبلدات والقرى. وكانت قُطعان الشَّبِّيحة واللصوص تدخل البيوت المهجورة و”تُعَفِّشها” (أي، تُجَرِّدها من “عفشِها،” أي، من أثاثها). وفي هذا السياق المشحون طائفيًا نشأت “سوقُ السُّنَّة” (هكذا بلا حياء)، ولا سيما في مدينة حمص، التي كانت تُباع فيها البضاعة المُعَفَّشة بأسعار بخسة. وهذا الاسم يدل على طائفتين تقفان على طرفي نقيض في الصراع الدائر: طائفة المُعَفِّشين وطائفة المُعَفَّش منهم. مع أنه، والحق يُقال، لم يقتصر المُعَفِّشون على أبناء الطائفة العلوية. فمع شيوع الفوضى وانفلات الوضع الأمني في سائر البلاد وتدهور الوضع المعيشي لمعظم السكان، انخرط أبناء كل الطوائف والفصائل المسلحة في تعفيش بيوت المُهَجَّرين والنازحين.
الجُمْلوكية
لم تَشِعْ مفردة “الجُمْلوكية” كثيرًا في أوساط السوريين، وربما لم يكن السوريون هم أول من أطلق هذا المسكوك اللفظي الطريف الذي نُحِتَ من كلمتين (الجُمهورية + المَلَكية) للدلالة على الطبيعة المتناقضة لنظام الحكم في سوريا (أنا سمعتها أول مرة من معلق سياسي على قناة الجزيرة). فنظام الحكم في سوريا، نظريًا ودستوريًا، نظام جمهوري، ولكنه عمليًا نظامٌ مَلَكيٌّ (أو جمهورية وراثية)، إذ يرثُ الابنُ الحكمَ من أبيه لا بإرادة الناخبين. وأعتقد أن عدم شيوع مصطلح “الجُمْلوكية” راجع إلى تراجع الحديث السياسي عن طبيعة نظام الحكم الأسدي والانشغال بالجرائم التي ارتكبها منذ بداية الثورة إلى سقوطه.
المِنْقَدَّسْلِية
هذا من المصطلحات النادرة التي لم تلقَ رواجًا شعبيًا في الحقيقة، ولكنه جدير بالذكر في هذا المقام لسببين في رأيي: أولًا، لطرافة اشتقاقه ومناسبته للحديث عن المُجتَرحات اللفظية السورية في القرن الحادي والعشرين استجابةً للظروف التي سادت بعد 2011؛ ثانيًا، لأنه، بخلاف المصطلحات الأخرى التي ذكرتُها في هذا المقال، صدرَ عن تيارٍ علويٍّ لا عن تيارٍ سُنِّيٍّ. وطريقة اشتقاق هذا المصطلح تشبه طريقة اشتقاق “المنحبكجي” (لذلك لا داعي للخوض فيها مرة أخرى) إلا أنه بدلاً من استخدام اللاحقة التركية “جي” استخدم مبتكر هذا المصطلح اللاحقة التركية الأخرى “لي” التي تقابل ياءَ النسبة في العربية – كما في قولهم “موصِلّلي” (نسبةً إلى الموصل) أو “لُبنانلي” (نسبةً إلى لبنان).
باختصار، المِنْقَدَّسْلِي شخصٌ يُقدِّس نظام الأسد ورموزه تقديسًا أعمى. وقد نشرت صفحةُ “البهلولية نيوز” على الفيسبُك مقالاً ساخرًا بعنوان “تيار اللحّيسة المِنْقَدَّسْلية” بتاريخ 15 شباط 2021 أنقله لكم أدناه بشيء من التصرف والاختصار، وقد أشرت إلى هذا المقال في مقالة سابقة لي بعنوان “أرباب الشعائر التطبيلية” نشرتُها على موقع تلفزيون سوريا. يُعرِّف كاتب المقال هذا التيار بأنه تيار افتراضي اجتماعي شبه سياسي وشبه منظم ظهر منذ سنة 2012، ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي. يُعدّ هذا التيار – السوري بامتياز – من أخطر التيارات الفيسبوكية على الإطلاق. من الممكن أن يكون هذا التيار موجَّهًا، وقد يكون غير موجَّه، يعني غالبًا أعضاؤه من اللحّيسة بالفطرة أو بالوراثة. مهمة هذا التيار:1) إقناع المواطن السوري – مهما كان فقيرًا أو محتاجًا أو جائعًا أو منهارًا أو مُغتَصَبًا أو موؤودًا أو ميتًا – أن كل ما يصدر عن الحكومة يصب في مصلحته ومصلحة عائلته؛ 2) أن كل ما يتعرض له من خوازيق ما هي إلا مؤامرات خارجية تحيكها القوى الرجعية والإمبريالية بهدف تدمير القوى الممانِعة والمقاومِة في الشرق الأوسط؛ 3) الدفاع عن كل مسؤول (حالي، سابق، متقاعد، ميت) صار حديثَ الفيسبُك، أو تعرض للنقد بسبب عمل فاسد قام به؛ 4) خلق إشاعات مضادة والترويج لها، والسعي لإقناع الشارع الفيسبوكي أن هذا المسؤول محل ثقة أو قامة وطنية أو شيخ وآدمي وصاحب دين، وأن كل ما قيل أو حِيك حوله ليس إلا إشاعات مغرضة تصب في مصلحة الكيان الصهيوني وعائلة روتشيلد.
أبو كلسون
عندما اقتحم الثوار المُنْتَشُون قصورَ بشار الأسد في دمشق وحلب بعد فراره إلى موسكو في 8 كانون الأول 2024، عثروا على مفاجأة صادمة: ألبومات صور يظهر فيها الدكتاتور الهارب مرتديًا ملابس داخلية فاضحة. وسُرعان ما انتشرت هذه الصور كالنار في الهشيم، وبين عشية وضحاها صار لقبُ الأسد لدى عامة الناس “أبو كلسون”. لم يُخْلَع الأسد من سلطته فحسب، بل جُرِّد أيضًا من آخر مظاهر الهيبة، ربما حتى في أعين أنصاره السابقين. لم تكن الصور مجرد فضيحة شخصية، بل تجسيدًا بصريًا لسقوط الطاغية وخوائه الداخلي. فقد تحطمت أسطورةُ الجبروت والهيبة، وانكشفت هشاشةُ رجلٍ حكمَ بالحديد والنار، لينتهي أضحوكةً في ذاكرة السوريين الجمعية.
التكويع
شاع مصطلح “التكويع” بعد سقوط نظام الأسد وفراره هو وكبار زبانيته من البلاد. هنا انكشف مؤيدو الأسد السابقون (من شَبِّيحةٍ ونَبِّيحةٍ ومِنْحِبَّكْجيةٍ ومِنْقَدَّسْليةٍ)، ولم يعد لديهم من يُطبِّلون له أو يرتكبون المجازر من أجله، وسُدُّت الحدودُ في وجوه الراغبين في الفرار. ومن أبرز المُكَوِّعين كان بشار الجعفري، سفير بشار الأسد في موسكو، والفنان المسرحي دريد لحَّام، وعضو مجلس الشعب السابق شريف شحادة. لكن لا بد من الإشارة إلى أن تكويع هؤلاء وغيرهم كان على درجات. فمن المُكَوِّعين من أعلن ولاءه لنظام الحكم الجديد بقيادة أحمد الشرع (كما فعل دريد لحَّام)، أو رضي بالعمل تحت قيادته (كما فعل بشار الجعفري الذي ظل يعمل سفيرًا لسوريا في موسكو إلى أن أُقيلَ من منصبه)، ومنهم من اكتفى بانتقاد بشار الأسد ونظامه (كما فعل شريف شحادة).
بقي أن أشرح أصل مصطلح التكويع. يشير الكوع في المصطلح العامي السوري إلى المنعطف في الطريق (أو U-Turn). وفي الاصطلاح السياسي السوري، يشير التكويع إلى التغير المفاجئ في موقف الموالين لبشار الأسد من النقيض إلى النقيض. وبعد شيوع المصطلح بأيام، اجترحتُ أيضًا ترجمةً إنجليزيةً موازيةً لهؤلاء المُكَوِّعين هي U-Turners!
هكذا أبدعت القريحةُ الشعبيةُ السوريةُ مصطلحاتٍ موجِعةً – شَبِّيح، مِنْحِبَّكجي، مُعَفِّش، مِنْقَدَّسْلي، أبو كلسون، مُكَوِّع – لم تُستعمل لأغراض الفرز السياسي فحسب، إنما لتكون أيضًا سلاحًا لفظيًا مُبدِعًا لوصف سلوكيات شائنة ارتكبتها فئةٌ من “شركاء الوطن” لا تتورع عن أي موبقة إرضاءً للطاغية، بل لا تتردد في تغيير مواقفها إذا انقلبت موازين الصراع لصالح المعارضة. لكن، هل ستحتفظ الذاكرة الجمعية السورية بأي من هذه المسكوكات اللفظية الطريفة أم سيتكفل الزمن بإحالتها إلى بطون الكتب والدراسات التاريخية والاجتماعية؟ إن مصير هذه المصطلحات ليس لغويًا فحسب، بل سياسي واجتماعي أيضًا. فبقاؤها أو اندثارها على المدى القريب مرهون بقدرة أطياف الشعب السوري كافةً على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة وتجاوز جراح الماضي.
تلفزيون سوريا
——————————
رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا: إعادة تموضع وبداية شراكة مشروطة/ أحمد العكلة
21 مايو 2025
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في البلاد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أنه تم تعليق العقوبات على قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء) والنقل، مما يسهل إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية في البلاد. كما تم رفع العقوبات عن خمسة بنوك سورية رئيسية، ما يتيح لها الوصول إلى الأصول المجمدة وإجراء المعاملات المالية، وذلك إضافةً إلى تمديد الاستثناءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى، بما يسهل تنفيذ مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار.
اعتبر الخبير الاقتصادي فراس شعبو، في تصريح لـ”الترا سوريا”، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يمثل “نقطة تحول استراتيجية” في مسار الاقتصاد السوري، إذ من شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقًا واسعة في مجالات الاستثمار، وتُعيد الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحسّن صورة سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو أن رفع العقوبات، سواء الأوروبية أو الأمريكية، سيسرّع من إعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، ويُسهّل إعادة تفعيل نظام “السويفت” والتحويلات البنكية، ما يُتيح تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع مجددًا.
أثر العقوبات على التجارة والتمويل
وأشار شعبو إلى أن العقوبات الأوروبية شكلت مع نظيرتها الأمريكية تأثيرًا مزدوجًا على الاقتصاد السوري، انعكس سلبًا على حركة التصدير. وذكر أن سوريا كانت تُصدّر قبل عام 2011 ما يقارب 3.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي، وهو رقم انخفض بشكل كبير خلال سنوات الأزمة.
وأضاف أن مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي كانت تقدّم منحًا سنوية تتراوح بين 200 و250 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء، وهو ما فُقد خلال السنوات الماضية، مما أضر بشكل كبير بالنمو الاقتصادي.
ورغم تفاؤله بقرار رفع العقوبات، حذر شعبو من أن الاقتصاد السوري يعاني مشكلات بنيوية عميقة، تشمل ضعف البنية التحتية وقطاع النقل والطاقة، فضلاً عن تراجع أداء المصرف المركزي وضعف السيولة في القطاع المصرفي، مما يُعيق التعافي المبكر.
كما شدد على ضرورة تسريع عملية إعادة تأهيل البنية التحتية وتفعيل النظام المصرفي، محذرًا من أن أي تأخير في هذه الخطوات سيجعل الاستفادة من رفع العقوبات محدودة، ويُبقي التركيز على قطاعات مثل الزراعة والصحة فقط.
وفيما يخص جذب الاستثمارات، أكد شعبو أن المستثمرين، وخصوصًا من دول الخليج، أبدوا رغبة متزايدة بدخول السوق السورية، مستشهدًا بتصريحات الملياردير الإماراتي خلف الحبتور حول نيته الاستثمار في سوريا. لكنه شدد على أن هذا الانفتاح يتطلب توافر الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب ضمانات قانونية تحمي حقوق المستثمرين وتكفل الملكية الخاصة.
وأضاف: “نحتاج إلى قوانين واضحة، وإلى التخلي عن مفاهيم مثل التأميم وتغليب المصلحة العامة على حقوق الأفراد، وهي مفاهيم كانت تُنفّر المستثمرين سابقًا”.
هل رفع العقوبات كافٍ؟
ورأى شعبو أن رفع العقوبات، رغم أهميته، ليس حلاً سحريًا، بل فرصة يجب استغلالها من خلال إدارة رشيدة تعتمد على الشفافية والحوكمة وكفاءة في إدارة موارد الدولة. وأوضح أن الهيكلية الحالية للاقتصاد السوري تحتاج إلى تحديث عميق وإصلاحات حقيقية.
وفيما يتعلق بالقطاعات المتوقع أن تنتعش، حدد شعبو الطاقة والصحة والزراعة والطاقة المتجددة، كأبرز المجالات التي ستجذب الاستثمارات. أما عن تأثير رفع العقوبات على سعر صرف الليرة السورية، فرأى أن التأثير الحالي نفسي أكثر منه اقتصادي أو نقدي، موضحًا أن أي تحسّن في سعر الصرف سيكون لحظيًا ما لم يصاحبه تحسّن فعلي في المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن الأسعار في السوق لا تعكس سعر الصرف الرسمي، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، ما يُسبب خللًا واضحًا في السياسة النقدية.
واختتم شعبو حديثه بالتأكيد على أهمية تأسيس هيئة مستقلة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لمنع تكرار تجارب الفساد أو الهيمنة التي عانى منها الاقتصاد السوري في الماضي. وقال: “نحن لا نريد خلق شبكات تستفيد من الاقتصاد وحدها، بل نريد اقتصادًا يخضع لحوكمة شاملة تُحقق العدالة والاستفادة الجماعية”.
وختم قائلًا: “رفع العقوبات ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لفرصة حقيقية، يجب أن تُدار برؤى اقتصادية وتشريعات حديثة، بما يُسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن السوري خلال الفترة المقبلة”.
يؤكد الكاتب والباحث السوري، د. باسل معراوي، في حديثه لموقع “الترا سوريا”، أن سوريا تمثل جوارًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للقارة الأوروبية، نظرًا لقربها الجغرافي وتشاطئها مع دول القارة على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعل من عدم استقرارها مصدر تهديد مباشر للأمن الأوروبي.
ويشير معراوي إلى أن أوروبا، التي رسمت خريطة المنطقة السياسية عبر اتفاقية سايكس-بيكو، فقدت نفوذها فيها بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فانشغلت ببناء نهضتها الاقتصادية وتخلت عن أدوارها الجيوسياسية، لتتحول لاحقًا إلى “ملحق في المجرة الأمريكية”.
ومع اشتعال الصراع الدولي على الأراضي السورية، تنبّه الأوروبيون إلى غيابهم عن ساحة يتصارع فيها الإيرانيون والروس والأتراك والأمريكان والإسرائيليون، فيما تدفع أوروبا ثمن هذا الصراع من خلال موجات اللجوء، وانتشار الكبتاغون، وتسلل الإرهاب إلى عمق القارة.
يتعمق الاهتمام الأوروبي بسوريا، وفق معراوي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعدت حدته مع سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قلل من أهمية التزام واشنطن بحلف الناتو. هذا الواقع دفع الأوروبيين إلى التفكير بجدية في حماية أنفسهم ذاتيًا، والبحث عن تحالفات قريبة جغرافيًا،حيث تُعد سوريا أبرز الخيارات المتاحة.
ويوضح معراوي أن أوروبا تخلّت كليًا عن الطاقة الروسية بعد تفجير أنابيب “نورد ستريم 2″، وباتت تبحث عن بدائل في الشرق الأوسط. وهنا تبرز سوريا كممر محتمل للطاقة القادمة من الخليج، وكبلد واعد باكتشافات غازية بحرية، ما يجعل من استقرارها هدفًا أوروبيًا استراتيجيًا لا يمكن تحقيقه دون إنهاء العقوبات وإطلاق نهضة اقتصادية.
رسائل أوروبية للداخل والخارج: دعم الدولة السورية الجديدة
ويشير معراوي إلى أن الرسائل الأوروبية باتت واضحة، بدءًا من الداخل السوري، حيث توجه دعوة صريحة لدعم مسار التغيير السياسي، وحث الأقليات على التحاور والانخراط في مؤسسات الدولة الجديدة دون انتظار “حمايات خارجية”. فالاتحاد الأوروبي، بحسب معراوي، لن يدعم إلا الدولة السورية ومؤسساتها، وليس أطرافًا تتصارع على السلطة.
أما الرسالة الثانية فهي موجهة للخارج، وتؤكد أن أوروبا معنية بدعم سوريا وبناء علاقات مستقلة معها بعيدًا عن المواقف الأمريكية أو غيرها، وهو ما يعكس رغبة في بناء جسور تواصل وعلاقات مستقرة مع دمشق.
وفيما يخص تعقيدات الملف السوري، يرى معراوي أن الخلاف الأوروبي الحقيقي لا يكمن مع الولايات المتحدة أو الدول العربية، بل مع تركيا. فهناك حساسية أوروبية شديدة تجاه طموحات أنقرة الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والمياه الاقتصادية، كما هو الحال مع اليونان وقبرص.
ويشير إلى أن الدول الأوروبية ترفض بشكل قاطع انفراد تركيا بتسليح أو تدريب الجيش السوري الجديد، وتحاول كبح جماح النفوذ التركي المتزايد، وهو ما يفسر إصرار الرئيس الفرنسي على دعوة نظيره السوري لزيارة باريس بهدف كسر الجليد وفتح باب العلاقات.
ويختم معراوي بالتأكيد على أن الملف السوري، وخصوصًا ملف اللاجئين، أصبح قضية داخلية أوروبية. فهو يُستغل سياسيًا من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحملات الانتخابية، ما يجعل من تحقيق الاستقرار في سوريا هدفًا حيويًا يسحب هذه الورقة من يد خصوم الأنظمة الليبرالية.
وترى الحكومات الأوروبية، بحسب معراوي، أن العودة الطوعية لمن لم ينجحوا في الاندماج باتت خيارًا مقبولًا، خاصة في ظل غياب أفق واضح لحل دائم، الأمر الذي يعزز من ضرورة دعم الدولة السورية وتحقيق الاستقرار على أراضيها.
يرتبط استمرار رفع العقوبات الأوروبية بالتزام الحكومة السورية الجديدة بالعملية السياسية وتشكيل حكومة شاملة. الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه.
أكد د. زكريا ملاحفجي، أمين عام الحركة الوطنية السورية، في تصريح خاص لموقع “الترا سوريا”، أن خطوة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن النظام السوري لم تأتِ بشكل جزئي أو تدريجي، بل جرت بشكل كامل ومفاجئ، ما يشير إلى تحوّل واضح في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
وأوضح ملاحفجي أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بناءً على عدة اعتبارات، أبرزها قضية اللاجئين والضغوط المتزايدة من أجل تأمين بيئة مستقرة تسمح بعودتهم. وأضاف أن هناك مصالح استراتيجية أوروبية تتعلق بالممرات الدولية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكذلك بخطوط الطاقة القادمة من الخليج والعراق، والتي تمر عبر سوريا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة الأوروبية لم تكن معزولة، بل جاءت بعد “تجرؤ” الولايات المتحدة واتخاذها إجراءات مماثلة، مما أعطى الأوروبيين هامشًا أكبر للتحرك سياسيًا في هذا الاتجاه.
يمثل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تحولاً مهمًا في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد، لكنه لا يزال مشروطًا بالتغيير والإصلاح السياسي الحقيقي. المرحلة المقبلة ستحدد مدى نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
الترا سوريا
——————————————
من الميادين إلى المكاتب.. تحوّلات المنظمات السورية في زمن الحرب/ أنس الفتيّح
2025.05.23
في بداية الثورة السورية، لم تكن المنظمات الإنسانية مؤسسات ذات طابع إداري جاف، بل كانت تنبض بحب الناس، تولد حيث الحاجة، وتتحرك بدافع الضمير. حتى عام 2013، تأسّس أكثر من 500 كيان مدني محلي وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، معظمها بقيادة شباب لم يعرفوا شيئاً عن المأسسة أو الدعم الدولي، لكنهم عرفوا وجوه الجياع، وأسماء الأطفال الذين فارقوا مدارسهم، وخرائط القرى التي لا تصلها المساعدات.
في تلك اللحظة الحرجة من التاريخ السوري، غابت الدولة كمقدّم للخدمة، وحضرت فقط بجيشها الذي يقصف ويقتل، فحاول المجتمع المحلي عبر المنظمات المستحدثة سدّ الفجوة.
ففي القطاع الصحي مثلاً، انهارت 80% من المرافق الصحية في بعض المناطق المحررة، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2013. فانبثقت هذه المنظمات كأذرع للنجدة، وكاستجابة إنسانية تملأ الفراغ.
كانت المبادرات تبدأ بغرفة وبضع أدوية، ثم تتوسع لتصبح في عام 2014 مراكز صحية، يقدّم بعضها، حسب ما صرّحت منظمة أطباء بلا حدود، حوالي 5,000 خدمة طبية شهرياً. لم تكن الغاية من وجودها تسجيل الأرقام في قاعدة بيانات، بل خلق فرصة للحياة في قلب الموت.
تغيّر الإيقاع
مع دخول التمويل الدولي على الخط، بدأ مشهد العمل الإنساني يتبدل. في عام 2015 وحده، وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بلغ حجم التمويل المخصص لسوريا 3.3 مليارات دولار أميركي، وُزّعت على حوالي 350 منظمة دولية ومحلية. لكن المفارقة أن 40% فقط من هذه الأموال وصلت فعلياً إلى المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجاً، وفق تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش” عام 2016.
تدريجياً، بدأت لغة المشاريع تطغى على لغة الاحتياج، وبحلول عام 2017، أصبح 70% من المنظمات المحلية تعتمد كلياً على التمويل الخارجي، حسب دراسة لمركز بدائل البحثي، ما حوّل الأولويات من حاجات الناس إلى شروط المانحين. وحسب تقرير صادر عن اتحاد المنظمات الطبية السورية، أُغلق 60% من المراكز الصحية المؤقتة بسبب عدم الاستدامة المالية، في حين اختفت 75% من برامج التوعية المجتمعية لأنها لا تُنتج أرقاماً قابلة للقياس، وفق مسح أجرته منظمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان عام 2019.
من الميدان إلى الشاشة
في هذا التحوّل، أصبح العاملون في الميدان، الذين ما زالوا يستنشقون رائحة الطين والخوف، قلّة. تشير إحصائية صادرة عن منظمة العمل ضد الجوع في عام 2020 إلى أن 70% من موظفي المنظمات الدولية في سوريا لم يزوروا أبداً المناطق التي يقدّمون لها المساعدة، في حين يذكر تقرير للمرصد السوري للإغاثة، صدر عام 2020، أن عدد خبراء المشاريع ارتفع بنسبة 300% بين عامي 2016 و2020.
“كنا نكتب التقارير بالدم، فصرنا نكتبها بلغة المانحين”، يقول أحد العاملين الميدانيين الشاهدين على التحول، في دراسة لمعهد أبحاث العمل الإنساني عام 2022، تُثبت أن 85% من تقارير المنظمات تحوّلت إلى نماذج معيارية لا تسأل عن كيف يشعر الناجون، بل عن عدد المستفيدين شهرياً.
وفي مسح ميداني لمنظمة رصد أُجري عام 2023، لوحظ أنه حتى عمليات التوزيع نفسها لم تسلم من البيروقراطية، فقد أصبح 50% من وقت العاملين يُستهلك في تعبئة النماذج بدلاً من التواصل المباشر مع المستفيدين.
الانقسام الأخلاقي: المأساة الصامتة
في حين كان أحد المتطوعين في إدلب ينقل الإمدادات في عربة متهالكة عبر خطوط النار، رفض المدير في المقر الرئيسي في مدينة مطمئنة خارج سوريا توقيع مصاريف النقل لأن البند غير مدرج في الموازنة. هذه القصة تعكس واقعاً مؤلماً. يقول تقرير للتحالف السوري للمنظمات الإنسانية الصادر عام 2023 إن 60% من المنظمات الإنسانية استغنت عن مشاريع أكثر إلحاحاً لتوافق شروط الممول.
وظهر جيل جديد من “المحترفين” الذين يتقنون صياغة المقترحات الفنية، لكن، وفق استطلاع أجرته منصة سوريا الإحصائية عام 2024، فإن 40% منهم يعترفون بأنهم لا يعرفون واقع المخيمات. بل إن بعض التقارير، في تحقيق أجرته شبكة أريج الإعلامية عام 2023، كشفت أن 30% من مشاريع الإغاثة تُعدّل بياناتها لتناسب مؤشرات الأداء.
مفترق الطرق
أربعة عشر عاماً على انطلاق العمل الإنساني، وبعد سقوط الأسد، وبعد أن أصبح 90% من السوريين يرزحون تحت خط الفقر، وفق آخر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي عام 2024، تقف المنظمات السورية على مفترق طرق. السؤال ليس فقط: كيف نزيد التمويل ونفتح أبواباً جديدة ونعزّز استمراريتها؟ بل: كيف نضمن أن سبعة عشر مليون سوري بحاجة للمساعدة لن يتحولوا إلى مجرد أرقام في جداول؟
الخطر أبداً ليس أن تتحول المنظمات إلى مؤسسات تتبع الأنظمة واللوائح، بل أن تتحول إلى مؤسسات تنسى لماذا وُجدت. فالمأساة لا تكمن في الاحتراف، بل في تحويل المعاناة إلى سلعة.
كان الشاب بيلي ميلز، وهو من السكان الأصليين في أميركا، يجري حافياً في البراري وهو يغني للطبيعة، للأشجار والريح والمطر. كان الركض طقساً روحانياً، جزءاً من علاقة متناغمة مع الأرض. وفي يومٍ، رآه أحد صيادي المواهب ووجد فيه فرصة. اشترى لميلز لباساً رياضياً أنيقاً، وأحذية مريحة، وساعات توقيت، وقدم له تدريبات مكثفة، في مسارات مجهزة للسباق. وبالفعل، صار ميلز يركض أسرع، وصار عدّاءً ماراثونياً محترفاً، وفاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 1964. لكنه لم يعُد يغني.
العمل الإنساني في سوريا كان يغني للحرية والكرامة والعدالة. اليوم، وقد صار أكثر احترافية، يجد السير، لكن بصمت. صار يعرف كيف يملأ النماذج، لكنه نسي لماذا بدأ.
ربما آن الأوان لوقفةٍ مع “الهندي الأحمر” فينا، لا لنرفض الاحتراف، بل لنستعيد الغناء. فالسوري ليس رقماً في تقرير، ولا سطراً في خطة استجابة، هو إنسان، له قصة، وله حلم.
وإذا كان لا بدَّ من السباق، فلنعد إلى الغناء.. كي لا نصل إلى المستقبل بأقدامنا فقط، وقد خلّفنا وراءنا القلب والروح.
تلفزيون سوريا
————————————–
حول تنابز سوريين وفلسطينيين/ أسامة أبو ارشيد
23 مايو 2025
منذ انطلقت الثورة السورية ضدّ نظام الرئيس المخلوع بشّار الأسد (2011)، ثمَّة من يصرّ في الجانبَين السوري والفلسطيني على أن يضع طموحات الشعبين وآمالهما في الحرية والانعتاق والكرامة في سياقَين متناقضَين. بل ثمَّة من يذهب إلى أبعد من ذلك عبر التلميح أو التصريح بأن ثمَّة حالة من التنافي والتضادّ بين المشروعَين الوطنيَين، السوري والفلسطيني، على خلفية الموقف من إيران ووكلائها في المنطقة، وتحديداً حزب الله اللبناني، من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى. ففي حين يرى كثيرون من السوريين (محقّين) أن محور إيران في المنطقة خصم لهم وشريك في جرائم نظام الأسد ضدّهم، جادل بعض الفلسطينيين بأن هذا المحور، بل حتى نظام الأسد، حلفاء لقوى المقاومة الفلسطينية. طبعاً، لا يمكن موضوعياً إنكار الدور الإيراني وبعض وكلاء طهران في دعم المقاومة الفلسطينية تاريخياً، وتحديداً في إسناد قطاع غزّة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة، كما فعل حزب الله (حتى سبتمبر/ أيلول 2023) قبل أن يخرج من المعركة جرّاء الضربات الإسرائيلية القاسية التي تلقاها، والدور الحوثي المستمر. كما لا يمكن موضوعياً إنكار دور المحور الإيراني في الجرائم المرتكبة بحقّ الشعب السوري. المشكلة أن ثمَّة من لا يريد أن يُقرّ بأن إسرائيل هي العدو الاستراتيجي لأمّة العرب، بمن فيهم سورية، كما أن المشكلة أن كلا الطرفَين، المحسوبَين على السوريين والفلسطينيين (وهم وإن علت أصواتهم وغلب ضررهم ليسوا أغلبيةً)، لا يعترفان بتعقيدات المشهدَين وتشابكهما، كما أنهما لا يقبلان بنسبية مقاربتيهما وتقاطع المناطق الرمادية بينهما. وهكذا يستمرّ الاشتباك ومحاولات تسجيل النقاط الرخيصة في مرمى الطرفَين المتشاكسَين.
حتى هروب الأسد خارج سورية، أواخر العام الماضي (2024)، لم يزدد المشهد إلا قتامة بين من يصرّون على التأزيم في الجانبين السوري والفلسطيني، خصوصاً عندما أقدمت إسرائيل متذّرعة بسقوط النظام على التوغّل في الأراضي السورية وتدمير قدرات البلاد العسكرية، والعبث في النسيج الوطني السوري. كان ردُّ فعل النظام السوري الجديد (ولا يزال) سلبياً أمام الانتهاكات الإسرائيلية، في حين برزت أصوات سورية لا تكتفي بالقول إن سورية، المنهكة منذ 13 سنة من الحرب والتقويض الممنهج الذي أحدثه حكم آل الأسد 55 سنة، غير جاهزة (ولا قادرة) الآن على التصدّي لإسرائيل. بل إن بعض تلك الأصوات تطرّف في القول إن العداء مع إسرائيل ليس أولويةً سوريةً. واستغلّ بعض الفلسطينيين هذا المنطق ليدين مرحلة الرئيس أحمد الشرع زاعماً أن فيه تأكيداً لما كان يقوله من أن نظام الأسد كان ممانعاً، وأن إسرائيل كانت طرفاً في دعم الثورة ضدّه.
وما لبث أن تعزّزت أصوات هؤلاء عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشرع (14 مايو/ أيار الجاري) في الرياض، وأعلن رفع العقوبات عن دمشق. ثمَّ جاء كشف إسرائيل (18 مايو الجاري) استعادة مجموعة من الوثائق والصور والمتعلّقات الشخصية المرتبطة بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعدم في سورية عام 1965، من خلال تعاون بين الموساد وجهاز مخابرات أجنبي لم تحدّده. ولم يزد تقرير “رويترز” (20 مايو الجاري) الوضع إلا سوءاً، إذ نسبَ إلى ثلاثة مصادر، منها اثنان سوريان (كما زعم)، أن أرشيف كوهين قُدّم لإسرائيل من الحكومة السورية، في مبادرة غير مباشرة من الشرع لتهدئة التوتّر وبناء الثقة مع ترامب. وكان نظامَا الأسد، الأب (حافظ) والابن (بشّار)، قد حافظا على تلك الوثائق عقوداً طويلةً ورفضا تسلميها لإسرائيل. أمّا ثالثة الأثافي، فكانت في تصريح السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد الذي قال إنه التقى الشرع عام 2023 بتنسيق من “مؤسّسة بريطانية غير حكومية، متخصّصة في حلّ الصراعات، من أجل مساعدتهم في إخراج هذا الشاب (أحمد الشرع) من عالم الإرهاب وإدخاله عالم السياسة التقليدية”. وأضاف فورد: “عندما التقيته للمرّة الأولى حين كان اسمه الحركي الجولاني، جلست بجانبه، وقلت له باللغة العربية: خلال مليون سنة لم أكن أتخيّل أنني سأكون جالساً بجانبك. ونظر إلي وتحدّث بنبرة ناعمة قائلاً: ولا أنا”.
المعطيات السابقة حسّاسة جدّاً وخطيرة، وهي لا شكّ تستوجب حذراً سورياً من المسار الذي تُجرّ إليه القيادة الجديدة، ولا ينبغي أبداً أن يهوّن بعضهم الأمر، خصوصاً مع مطالبة ترامب الشرع بالتطبيع مع إسرائيل. هي عملية ابتزاز مكتملة الأركان؛ عقوبات أميركية وغربية مُذخّرة بغرض الابتزاز والإخضاع في ظلّ وضع اقتصادي منهار ودمار هائل في البلاد؛ اعتداءات إسرائيلية سافرة ونصائح من بعض الأطراف العربية للقيادة الجديدة بالسير في ركاب المطبّعين ومحور الثورات المضادّة؛ فتنة طائفية داخلية تعبث فيها أصابع خارجية وفوضى تحدثها، وجرائم يقترفها أنصار النظام السابق؛ أخطاء يرتكبها الحكم الجديد. إلا أن المبالغة في التحريض على سورية الجديدة وافتراض سوء النيات والميل إلى تصديق فورد، وتكذيب التوضيح السوري الذي أكّد أن زيارة فورد إلى إدلب “كانت كما غيرها من زيارات الوفود الأجنبية جزءاً من الاطلاع المباشر على التجربة الثورية السورية وتطوّرها في المناطق المحرّرة، ومحاولة فهم واقعها ومراحلها”، لا يفيد فلسطين قطعاً. هذا لا يعني أن نكون ساذجين، لكن موضعة سورية الجديدة في خانة خصوم القضية الفلسطينية عربياً، من دون إعطاء فرصةً لها، قد تترتب عنها تداعيات كارثية. يتطلّب الأمر توثقاً أولاً، خصوصاً أن الشعب السوري، وليس نظامه الجديد فقط، يطالب بفرصة لالتقاط الأنفاس. ومن ثمّ، ليس من المصلحة أن نجعل الأمر مزايدةً على أيّ الشعبين أكثر ألماً ونزفاً، الفلسطيني أم السوري. في المقابل، على سورية الجديدة أن تدرك أن إسرائيل هي عدوها الأوّل، كانت وما زالت وستبقى. وتبنّي مقاربة أمنية وطنية سورية تحدّد إسرائيل تهديداً أعلى لها هي حماية لسورية وليست وفاءً لفلسطين فحسب.
جدل الأولويات الفلسطينية السورية ما هو إلا تعبير واحد عن عمق أزمتنا أمّةً عربيةً، إذ إن غياب المقاربة القومية الجمعية يجعلنا جميعاً قابلين للابتزاز، ولضرب بعضنا ببعض. وحتى تكون هناك مقاربة قومية جمعية عربية، وهو أمر غير متصوّر في المدى المنظور، فليس أقلّ من أن نسعى إلى تقليل التناقضات الشعبية البينية، خصوصاً عندما يكون طرفا المعادلة كلاهما ضحايا ومكشوفين وقابلين للابتزاز. لكن، إن ثبت أن طرفاً ما يسير في الطريق الخاطئ قاصداً (متعمّداً) خدمة أهداف مناقضة لمصالحنا أمّةً وشعوباً، حينها يكون لكلّ حادث حديث. حتى ذلك الحين، سننتقد ونحذّر وننصح، لكنّنا لا نصدر أحكاماً راهناً ونتلمّس الأعذار، من دون أن نقع في وحل السذاجة.
كلمة أخيرة، عار على كلّ من ينفخ في كير فتنة فلسطينية سورية. وعار على كلّ من لا يتفهّم إكراهات الطرف الآخر، وعار على كلّ من يبرّر لإسرائيل وجرائمها ولا يقف مع إخوانه المظلومين في فلسطين. إسرائيل عدونا الجمعي. أحمق وسفيه وخائن من لا يرى ذلك ويعتقده يقيناً.
العربي الجديد
———————————-
سلامة كيلة يعود إلى دمشق/ سامي حسن
23 مايو 2025
أُعلن من منزل الراحل سلامة كيلة في دمشق، في 17 مايو/ أيار الجاري، تأسيس منتدى سلامة كيلة الثقافي (قيد الترخيص). إذ شارك في الاجتماع التأسيسي مقيمون في سورية وآخرون في خارجها (عبر تقنية الزوم)، انتخبوا مجلساً لإدارة المنتدى.
بدأ الاجتماع التأسيسي بكلمة ناهد بدوية، قالت فيها إنها، بعد سقوط نظام الأسد، “فكّرت فوراً بإعادة النشاط إلى هذا المنزل الذي لم يكن مجرّد بيت عائلي، بل كان مقرّاً للنشاطات… اجتماعات الحوار بين القوى اليسارية السورية المعارضة في أواخر الثمانينيات، اجتماعات مجموعة البديل لمناهضة العولمة 2004، ندوات منتدى اليسار، اجتماعات متنوّعة من أجل الديمقراطية مع المجموعات والمنتديات المشاركة في ربيع دمشق ومع رياض الترك أثناء نقاش الموضوعات ومناقشة إعلان دمشق… إلخ، اجتماع تأسيسي لنساء من أجل الديمقراطية 2006، اجتماعات ائتلاف اليسار في الثورة السورية، اجتماعات نساء من أجل الانتفاضة السورية، وشهد اعتقال سلامة منه مرّتين، واعتقالي مرّتين”. وختمت “هُويَّة المنتدى ستكون محصلة ذواتنا المتنوعة أعضاءً وفاعلين فيه. فنحن يساريون وديمقراطيون وناشطون على أرضية ثورة الحرية، التي سنبقى ندافع عن قيمها في الحرية والعدالة والمساواة، وسوف يكون تركيزنا على العدالة الاجتماعية، هو ما سوف يميز هُويَّة منتدانا هذا”.
إذاً، اعتقل سلامة كيلة في سورية مرّتَين. الأولى بسبب نشاطه السياسي المعارض لنظام الأسد الأب، ودفع ثمن ذلك ثماني سنوات (1992-2000)، قضاها في سجنَي عدرا وتدمر. واعتقاله الثاني في 2012، الذي أُبعد في أثره إلى الأردن، فقد جاء على خلفية انخراطه في الثورة ضدّ نظام الأسد الابن. بينما كان بعض اليساريين يُعلن صراحةً عدم تأييدهم الثورة السورية التي انطلقت في مارس/ آذار 2011، ويوجّه سهامه ضدّها، بل وينفي عنها أصلاً أنها ثورة، تحت ذرائع مختلفة (هيمنة القوى الإسلامية وخطابها، وخروج التظاهرات من المساجد،… إلخ). كان سلامة من فرسان الثورة، ومنظّراً لحتمية انتصارها. وهذا لا يعني أنه لم يكن يرى الأخطاء والسلبيات، أو أنه كان راضياً عن أداء المعارضة، أو متجاهلاً هيمنة قوى الإسلام السياسي، ولا سيّما السلفية التكفيرية منها. على العكس، اتخذ موقفاً نقدياً حادّاً من المعارضة. ومنذ اللحظات الأولى لبروز ظاهرة “الأسلمة”، أشهر مبضع نقده لها، منبّهاً إلى خطورتها، بل إنه ربط انتصار الثورة بتهميش هذه القوى وإضعافها، لكن ليس من خلال النقد فحسب، بل عبر الانخراط الفاعل في الثورة والعمل في الأرض.
بعد خروجه من سورية، أمضى سلامة كيلة حياته متنقلاً بين القاهرة وعمّان. ورغم مرضه الشديد والمُنهِك، إلا أن عزيمته لم تفتر، فواصل نشاطه السياسي والتنظيمي والفكري، فضلاً عن كتاباته الصحافية، لا سيّما في صحيفة العربي الجديد، التي خصّته بزاوية أسبوعية، أطلّ من خلالها على القرّاء بمواضيع متنوعة وثرية، فلسطينية وعربية وعالمية، سياسية وفكرية، عكست انحيازه إلى قضايا الشعوب، وحضرت فيها سورية وثورتها، وتفاؤل سلامة المعهود. في 12 يوليو/ تموز 2018، وتحت عنوان “عن سحق الثورة”، كتب سلامة: “لكن هذه ليست النهاية، إنها نهاية مرحلة. لقد سحقت الثورة ولم ينته الصراع، وليس من أملٍ بأن ينتهي ما دام الشعب يريد إسقاط النظام… الثورات تُسحق، لكنّها لا تموت. ستنهض الثورة من جديد، لا شكّ في ذلك، كما الثورات في البلاد العربية، في عالم عاصفٍ ومحمّلٍ بمخاض كبير”. استمرّ سلامة في كتابة زاويته حتى آخر نَفس. ففي تاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2018، قبل وفاته بأيّام، نُشِرت آخر مقالاته “في الموقف ضدّ الاستبداد”.
سقط نظام بشّار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتحقّقت نبوءة سلامة كيلة، الذي لو كان حيّاً، لشدّ رحاله إلى دمشق في اليوم التالي للسقوط. ولنا أن نتخيّل كيف كان سيلاحق السلطة الجديدة “على الدعسة”، مشرّحاً ومنتقداً ومستشرفاً مواقفها وسياساتها، داعياً إلى ضرورة الإسراع في العمل والتنظيم بين الناس، وفي النقابات…إلخ. لو كان سلامة بيننا، لتحوّل بيته خلية نحل تعمل ليل نهار من أجل استكمال أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية والمساواة.
كانت “راجع” آخر كلمات سلامة كيلة التي ردّدها بثقة وهو يغادر منفياً إلى الأردن في 2012. لم يتمكّن من العودة إلى سورية، إذ وافته المنية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ووري جثمانه في الثرى في عمّان، بعد رفض إسرائيل دفنه في مسقط رأسه بيرزيت بفلسطين. لكن محبّي سلامة، عرباً وكرداً، سوريين وفلسطينيين، ومن خلال المنتدى الذي سمّي باسمه، قد أعادوه روحاً وفكراً وإرثاً، إلى البلد التي أحبّ، وإلى داره في دمشق.
—————————–
سوريا ما بعد الأسد.. تمثيل النساء بين الرمزية والإصلاح الحقيقي
22 مايو 2025
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 13 أيار/مايو أنها سترفع العقوبات عن سوريا بشروط معينة، تشمل تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وهو ما يُعد بمثابة شريان الحياة لسوريا التي تحتاج إلى بدء إعادة الإعمار، والتقدم نحو مستقبل أكثر ديمقراطية، بحسب تقرير صادر عن معهد “جورج دبليو بوش” الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنه في أعقاب الإطاحة بنظام الدكتاتور السوري بشار الأسد أواخر عام 2024، تم تشكيل الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، والتي عيّنت بدورها المدافعة البارزة عن حقوق النساء والمعارضة الشرسة للاستبداد، هند قبوات، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وهي المرأة الوحيدة التي تشغل منصبًا وزاريًا في سوريا حاليًا.
وأضاف المعهد أن تعيين قبوات في هذا المنصب يُعد “خبرًا سارًا”، لكنه مجرد نقطة انطلاق لقادة سوريا الجدد إذا أرادوا تجاوز تاريخ البلاد في إقصاء النساء. كما اختارت الحكومة المؤقتة بعض النساء للمساهمة في عملية الإصلاح الدستوري، حيثُ عملت خبيرتان قانونيتان، هما ريعان كحيلان وبهية مارديني، في اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء والمسؤولة عن صياغة الدستور.
ومع ذلك، يقول المعهد إنه ينبغي على سوريا بذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة فاعلة للمرأة في المجتمع المدني، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لاستفادة المجتمع من مشاركة النساء في الحوارات السياسية.
ويوضح التقرير أن الحركات التي تقودها النساء دائمًا ما تكون أكثر سلمية وقدرة على تحقيق التغيير الديمقراطي، لافتًا إلى أن من شأن التنوع الجندري في الحكومات والمنظمات الخاصة أن يؤدي إلى انخفاض الفساد وزيادة الشفافية والنجاح، مضيفًا أنه عندما تتولى النساء مناصب قيادية، يتراجع خطر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مؤسسات الدولة.
وأضاف التقرير أن المساواة الجندرية تُعتبر من أقوى الأدوات لمكافحة صعود الاستبداد والتطرف وتراجع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى اعتماد الأنظمة الاستبدادية على النظام البطريركي لاحتفاظ السلطة والسيطرة على السكان، وعندما تُمكّن النساء، لا يمكن للاستبداد أن يستمر. كما أن المجتمعات تزدهر عندما تتولى النساء أدوارًا فاعلة، ودعم لأصوات النسائية يدعم أيضًا عالمًا أكثر حرية وازدهارًا.
ويذكّر التقرير بأن قبوات كانت من أشد معارض نظام الأسد، متهمةً نظامه بإعطاء النساء أدوارًا “شكلية” فقط في المجتمع. وقد تم نفيها عام 2011 بسبب نشاطها السياسي، لكنها في عام 2015 أسست منظمة “تستقل”، وهي منظمة غير ربحية تُركّز على بناء سوريا ديمقراطية من خلال تدريب النساء على الحوار بين الأديان وحل النزاعات. كما أنها محامية واقتصادية، شغلت منصب نائب مدير مكتب جنيف لهيئة المفاوضات السورية من عام 2017 حتى عام 2022.
ومنذ سقوط نظام الأسد، وُجّهت دعوات دولية وداخلية لزيادة الأصوت النسائية في الحكومة الجديدة. وفي أول يوم لها في منصبها كوزيرة، أكدت قبوات للرئيس الشرع على ضرورة إشراك المزيد من النساء في الحكومة. بدورها، وعدت الحكومة الانتقالية بزيادة تمثيل النمساء وحماية حقوقهم. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ العملي على نطاق أوسع بطيئًا، مما يُثير قلق النشطاء.
واجهت النساء خلال السنوات الـ14 الماضية، في ظل نظام الأسد، أشكالًا متعددة من التمييز وعدم المساواة، ما يثير مخاوف من تراجع حقوقهن في عهد حكومة الشرع، بحسب التقرير ذاته.
وكان الشرع قائدًا لجماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية المعارضة، وهي أحد أفرع تنظيم القاعدة في سوريا حتى عام 2016، وقد أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2018. وبعد سقوط نظام الأسد، عملت الهيئة على حل نفسها رسميًا، واندماجها في مؤسسات الدولة.
ووفقًا لتقرير المعهد، فإن سجل الهيئة، بصفتها منظمة سلفية جهادية، لم يكن حافلًا في مجال حقوق النساء والأقليات، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل، حيثُ ضمت تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها الشرع وزراء من الأقليات الدينية والعرقية، إلا أن ذلك لا يعني تجاهل صلته بالهيئة.
ولفت التقرير إلى أن سوريا تعاني من وضع اقتصادي هشّ، فضلًا عن دمار واسع في البنية التحتية، وعلى هذا الأساس يخلص المعهد في التقرير إلى تقديم التوصيات التالية:
لضمان وفاء الشرع بوعوده المتمثلة بالمشاركة السياسية الشاملة والالتزام بمبادئ الديمقراطية، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها الدفع نحو إشراك أكبر للمرأة في أدوار صنع القرار، وزيادة الاستثمارات في فرص بناء القدرات التي تدعم القيادات النسائية.
يُعدّ إشراك النساء في الحكومة السورية خطوةً إيجابيةً نحو السلام الدائم والديمقراطية في البلاد، نظرًا لما يُمثله دور النساء في إعادة بناء سوريا وانتقالها إلى الديمقراطية.
إنّ ترقية امرأةٍ مثل قبوات علامةٌ جيدة، ولكن نأمل أن تكون مجرد بدايةٍ لاستقرارٍ وتغييرٍ أوسع. وتبدو هذه الخطوات المبكرة نحو مشاركة النساء في الحياة السياسية مهمة، لكن فقط إذا واصلت الحكومة السورية التزامها بتحسين وحماية حقوق النساء في البلاد بشكل دائم.
تبدو الأفعال أبلغ من الأقوال، ولذا على المجتمع الدولي أن يُلزم الشرع وحكومته بالوفاء بوعودهما.
الترا سوريا
———————————–
==========================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 23 أيار 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
——————————————-
إلقاء السلاح.. تأثيرات على الحكومة السورية مع “قسد”/ عبد اللطيف نايف البصري
2025.05.23
شهدت الساحة السورية تطوراً لافتاً في الأيام القليلة الماضية مع إعلان حزب العمال الكردستاني قراره التاريخي بحل نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك صراعاً مسلحاً استمر لأربعة عقود. يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، بعد شهرين فقط من توقيع اتفاقية بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا.
خلفية قرار حزب العمال الكردستاني
أعلن حزب العمال الكردستاني في 12 من مايو/أيار 2025 قراره بحل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا، وذلك في ختام مؤتمره الثاني عشر. وقد أوضحت وكالة “فرات” المقربة من الحزب أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء “الكفاح المسلح” وجميع الأنشطة التي تتم باسمه، معتبراً أنه “أنجز مهمته التاريخية”.
وعند تأمل هذا القرار، أجد أنه يمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في فكر الحركة الكردية المسلحة التي طالما آمنت بأن السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبها.
فالحزب الذي قاد تمرداً استمر لأربعين عاماً، يقر الآن بأن “الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية”، وهو ما يعكس تحولاً نحو العمل السياسي بدلاً من المسلح.
العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقسد
تتسم العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالتعقيد والتداخل التنظيمي. فرغم نفي قيادة قسد وجود علاقات رسمية مع الحزب، إلا أن مصادر متعددة تؤكد وجود ارتباط أيديولوجي وتنظيمي بينهما.
وكشفت مصادر خاصة أن الكوادر القيادية في قسد تتلقى توجيهاتها من شخصية تُعرف بلقب “الدكتور”، وهي غير سورية تقيم في جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني.
كما أن غالبية المقاتلين الأجانب في قسد سيغادرون الأراضي السورية بعد إعلان حل الحزب، حيث خرج عدد كبير منهم بالفعل.
وفي تقديري، فإن هذا التداخل التنظيمي يجعل من الصعب فصل مصير قسد عن قرار حزب العمال الكردستاني، رغم محاولات قيادة قسد التنصل من هذا القرار والتأكيد على استقلاليتها. فالجذور الفكرية والتنظيمية المشتركة تجعل من المستبعد أن يكون قرار الحزب بمعزل عن مستقبل قسد في سوريا.
الاتفاقية بين الدولة السورية وقسد
في 10 من مارس/آذار 2025، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
تضمنت الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية، أبرزها:
• ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
• الاعتراف بالمجتمع الكردي كمجتمع أصيل في الدولة السورية.
• وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.
• دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية.
• ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم.
وأرى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو إعادة توحيد الأراضي السورية وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. لكن نجاحها يظل مرهوناً بمدى التزام الطرفين بتنفيذ بنودها، وبالتطورات الإقليمية المتسارعة، ومنها قرار حزب العمال الكردستاني.
تأثير قرار العمال الكردستاني على الساحة السورية
التأثير السياسي
يعزز قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح موقف الحكومة السورية في مفاوضاتها مع قسد، إذ يضعف الموقف التفاوضي للأخيرة التي كانت تستمد قوتها جزئياً من علاقتها غير المعلنة مع الحزب. كما يفتح الباب أمام تسريع تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدمج المؤسسات العسكرية.
وفي رأيي، فإن هذا التطور قد يدفع قسد إلى تقديم تنازلات إضافية للحكومة السورية، سعياً للحفاظ على مكتسباتها في ظل تراجع دعمها الإقليمي. كما أنه يعزز فرص نجاح المسار السياسي السوري، شريطة أن تستثمر دمشق هذه الفرصة بحكمة، وأن تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية بحسن نية.
التأثير الأمني
من الناحية الأمنية، يمكن أن يسهم قرار الحزب في تحسين الوضع الأمني في شمالي سوريا، خاصة مع توقعات مغادرة المقاتلين الأجانب للأراضي السورية. كما أنه قد يقلل من حدة التوتر بين تركيا وقسد، مما يخفف الضغط العسكري التركي على الحدود السورية الشمالية.
لكنني أرى أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال ظهور خلافات داخل صفوف قسد حول كيفية التعامل مع هذا المتغير الجديد، مما قد يؤدي إلى انشقاقات أو صراعات داخلية تهدد استقرار المناطق التي تسيطر عليها. كما أن هناك تساؤلات حول مصير الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة عناصر الحزب في سوريا.
التأثير الاقتصادي
اقتصادياً، يمهد قرار الحزب الطريق أمام تنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بدمج حقول النفط والغاز ضمن إدارة الدولة السورية، مما قد يعزز موارد الدولة ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأعتقد أن عودة السيطرة على الموارد الطبيعية في شمال شرقي سوريا إلى الدولة المركزية ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري ككل، شريطة أن يتم استثمار هذه الموارد بشكل عادل يضمن تنمية المناطق المتضررة من الصراع.
خاتمة
يمثل قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح وحل نفسه نقطة تحول محورية في المشهد السوري، إذ يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأوراق في الشمال السوري، ويعزز فرص نجاح الاتفاقية بين الدولة السورية وقسد. لكن تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، وتجاوز عقود من الصراع والانقسام.
وفي النهاية، أرى أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة السوريين على بناء دولة تتسع للجميع، تحترم التنوع وتضمن الحقوق، وتنبذ العنف كوسيلة لتحقيق المطالب السياسية. فالتحول من لغة السلاح إلى لغة السياسة هو الطريق الوحيد نحو سوريا مستقرة وموحدة.
تلفزيون سوريا
———————————-
قسد بعد قنديل.. بين إرث العمال الكردستاني وشروط الوطنية السورية/ باسل المحمد
2025.05.20
في تحول إقليمي لافت أعلن حزب العمال الكردستاني، المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة، عن حل نفسه وإنهاء تاريخه العسكري الممتد لعقود، تاركاً وراءه إرثاً من الصراع والتحالفات والدماء، معتبراً في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء المقرّبة منه، أنه أنجز “مهمته التاريخية” و”أوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية”.
إلا أن الصدى الأكبر لهذا الإعلان لم يكن في تركيا أو شمال العراق، بل في شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، القوة التي شُكلت برعاية أميركية لمحاربة تنظيم “داعش”، لكنها وُصمت مراراً خصوصاً من قبل أنقرة بأنها “امتداد سوري” لحزب العمال الكردستاني. هذا الاتهام الذي ظل يلاحق قسد منذ تأسيسها عام 2015، شكّل عائقاً كبيراً أمام قبولها كجزء من أي حل سياسي شامل في سوريا، لا سيما بعد سقوط النظام وتشكيل إدارة انتقالية جديدة في دمشق تسعى لفرض سيادتها على كامل الجغرافيا السورية.
ومع إعلان الحزب الأم حل نفسه يبرز سؤال محوري: هل يُفتح الباب أمام إعادة تعريف قسد كقوة عسكرية وسياسية سورية خالصة منزوعة الصبغة الأيديولوجية العابرة للحدود؟ وهل يشكّل هذا التطور مدخلاً لشرعنتها في الداخل السوري ومنحها دوراً في مستقبل البلاد، أم أن إرثها التنظيمي العميق وعلاقاتها المعقدة مع قيادات العمال الكردستاني سيظل عقبة يصعب تجاوزها حتى لو اختفى الحزب شكلياً من المشهد؟
قسد وضرورة مراجعة الإيديولوجية
رغم المساعي السياسية والإعلامية التي تبذلها “قوات سوريا الديمقراطية” لتقديم نفسها كقوة سورية محلية ذات طابع تعددي، لكن في العمق لا تزال البنية الفكرية والتنظيمية لقسد ترتكز على مرجعية واحدة، هي فكر عبد الله أوجلان، الزعيم المؤسس لحزب العمال الكردستاني، وصاحب النظرية التي تُعرَف باسم “الأمة الديمقراطية”، والتي تتبناها الإدارة الذاتية بشكل رسمي.
ينعكس هذا الارتباط الفكري بعقيدة “العمال الكردستاني” في البنية الإدارية والسياسية والعسكرية؛ فالمحتوى التعليمي الذي يدرّس في مدارس الإدارة الذاتية يتضمن مفاهيم ونصوصاً مستمدة من فكر عبد الله أوجلان، إضافة إلى أن اللغة الإعلامية والسياسية التي تتبناها قسد وإدارتها الذاتية لا تزال تعكس بوضوح تأثيرات الخطاب السياسي للعمال الكردستاني.
أما الناحية الأهم فهي العلاقة والامتداد في بنية القيادة والقرار، فالكثير من القيادات العسكرية في قسد ينحدرون من خلفية حزب العمال الكردستاني، أو تلقوا تدريبهم في معسكرات قنديل، كما أن القوى العسكرية الضاربة في قسد هي حزب الاتحاد الديمقراطي، وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب الكردية” الذي تأسّس في العام 2003 على اعتباره نسخة سورية من حزب العمال.
ورغم أهمية الحديث عن حل حزب العمال الكردستاني كخطوة سياسية قد تُفتح بها نوافذ تفاهم مع أطراف إقليمية مثل تركيا، فإن الإشكال مع قسد لا يكمن فقط في صلاتها التنظيمية مع الحزب، بل في الأساس الفكري الذي تنطلق منه، والذي يحمل هوية تتجاوز الدولة السورية وحدودها.
وبناء عليه يرى مراقبون أن أي مسعى لشرعنة قسد في السياق السوري لا يمكن أن يُبنى على خطوات تجميلية أو إجراءات شكلية، بل يتطلب مراجعة حقيقية للمرجعية الإيديولوجية، وآلية بناء القرار داخل هذه القوات، وهيكلة العلاقة بين السياسي والعسكري فيها.
تفكك العمال الكردستاني.. ونهاية الأذرع العسكرية
يمثل الحديث عن تفكيك حزب العمال الكردستاني نقطة تحوّل مفصلية لا على مستوى تركيا وحدها، بل على امتداد خريطة الانتشار المسلح الكردي في الإقليم. فالحزب مع مرور السنوات لم يعد مجرد كيان محلي، بل تحول إلى شبكة عسكرية متعددة الفروع، تتوزع في سوريا والعراق وإيران، وتحمل العقيدة الإيديولوجية والتنظيمية نفسها.
وبناء يبدو حل الحزب الأم بمنزلة الزلزال السياسي الذي قد يدفع تلقائياً إلى انحلال البُنى المسلحة التابعة له، أو على الأقل إعادة هيكلتها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية. وهنا تحديداً تدخل قوات سوريا الديمقراطية على خط التأثر المباشر، ففي ظل ما يشهده المشهد السوري من محاولات لبناء شرعية جديدة على أسس وطنية، فإن تخلّي قسد عن جناحها العسكري المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية YPG أو فصله عن هيكلها السياسي، سيكون بمنزلة خطوة حاسمة نحو شرعنتها.
وفي هذا السياق يرى الباحث في مركز الشرق الاستراتيجي محمد أمين جنكيز أنه بناء على قرار العمال الكردستاني حل نفسه فإن قوات “قسد” باتت الآن قادرة على التحرر من وصاية قنديل، ولديها فرصة حقيقية للتحول بحيث تصبح قوة سورية خالصة، لا جناحاً سورياً لحزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق أمامها للحصول على الشرعية الوطنية.
ويرى جنكيز أن قرار الحل، إضافة إلى التغييرات الإقليمية والدولية تشير إلى أن الوجود الأميركي في سوريا لن يدوم إلى الأبد، ما يعني أن قوات سوريا الديمقراطية مضطرة إلى التوصل إلى تفاهم مع القيادة الجديدة في دمشق، ودمج مؤسساتها العسكرية والإدارية ضمن الإدارة السورية الجديدة، لا أن تبقى فرعاً لتنظيم إرهابي عابر للحدود.
ويشار إلى أنه إضافة إلى قوات “قسد” يوجد العديد من التنظيمات المنبثقة عن العمال الكردستاني في الإقليم منها “قوات الدفاع الشعبي” (HPG) في العراق، وجماعة “بيجاك” (PJAK) في إيران.
نهاية الأسباب التركية وفتح باب شرعية قسد
لطالما استخدمت تركيا العلاقة التنظيمية والإيديولوجية بين “قوات سوريا الديمقراطية” وحزب العمال الكردستاني كذريعة رئيسية لتبرير تدخلاتها العسكرية المتكررة شمال شرقي سوريا، مستندة إلى تصنيف دولي للـعمال الكردستاني كتنظيم إرهابي، إلا أن تفكيك الكيان الأم قد يسحب هذه الذريعة من يد أنقرة، ويضعها أمام واقع سياسي جديد، خاصة إذا رافق ذلك خطوات من قسد لتفكيك جناحها العسكري أو إعادة صياغة هويتها السياسية.
مثل هذا التحول يراه مراقبون أن من شأنه ليس فقط أن يقلل من مبررات الهجمات التركية، بل أن يخلق بيئة سياسية جديدة قد تفتح الباب أمام دمج قسد كتيار سياسي ضمن المشروع الوطني السوري. لا سيما في ظل التقارب بين دمشق الجديدة وأنقرة، وتطابق في أولويات الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب.
من ناحيته يعتقد الباحث الكردي أسامة شيخ علي أنه مع حل حزب العمال الكردستاني انتفى هذا السبب الرئيسي لاستهداف تركيا قيادات وكوادر قسد، والمتعلق بتصنيفهم على قوائم الإرهاب التركية بسبب ارتباطهم بالتنظيم الأم في جبال قنديل.
وبالنسبة لمصير هؤلاء الكوادر المرتبطين بالعمال الكردستاني يوضح شيخ علي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه سيتم التعامل معهم بناء على المباحثات القائمة بين الحكومة التركية والحزب؛ بمعنى سيتم تسوية أوضاع العناصر التركية، أما السوريون المنتمون إلى الحزب فسيبقون في سوريا ضمن تسوية تتفق عليها قسد مع الحكومة في دمشق.
من جانبه يتوقع الباحث جنكيز أنه إذا سارت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بسلاسة، فمن المرجح أن تتراجع حدة التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية تدريجياً، لا سيما أن اتفاق الرئيس الشرع ـ عبدي أسهم بشكل كبير في تراجع التهديدات التركية ضد قسد في الآونة الأخيرة، وهذا كله يشكل خطوة أساسية في الطريق إلى شرعنة وجود قسد على الأراضي السورية.
وكانت صحيفة حرييت التركية ذكرت في تقرير عن مصير المقاتلين في حزب العمال الكردستاني بعد إعلانه حل نفسه أن أنقرة تتوقع أن تكون العملية في الميدان السوري تطبيقاً للاتفاق المكون من 8 مواد الذي وقعته “قوات سوريا الديمقراطية” وحكومة دمشق، وأضافت الصحيفة أن تركيا وحكومة دمشق ستظلان مصممتين على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم السماح بوجود نظام فيدرالي أو مستقل.
قسد من العسكرة إلى السياسة
تشير معطيات ميدانية وسياسية متطابقة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” بدأت بإعادة تموضع داخلي قد يُفضي إلى تحوّل في طبيعة دورها من كيان عسكري إلى طرف سياسي، كشرط للبقاء في المشهد السوري الجديد الذي يتجه نحو تسويات سياسية تتطلب أطرافاً مدنية قابلة للدمج لا تنظيمات مسلحة مرتبطة بصراعات إقليمية، إضافة إلى ما تمثله خطوة إعلان حزب العمال حل نفسه من تفكك في المرجعية الإيديولوجية لقسد بشكل عام.
وعن إمكانية تحول قسد إلى حزب سياسي يعتقد الباحث شيخ علي أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً سياسياً أكبر لحزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح العسكري لقسد)، خصوصاً أنه تخلص من أعباء الارتباط بالإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى فإن حزب العمال له موارد مالية ضخمة قد يسهم حصول “الاتحاد الديمقراطي” على جزء منها في بناء قاعدة شعبية تساعده للعمل ضمن الفضاء السوري العام من دون الانغلاق في الحيز الكردي فقط.
ويرى شيخ علي أنه إذا تضمن الدستور السوري المقبل الاعتراف بالوجود الكردي في سوريا، وتوسيع صلاحيات البلديات المحلية للمناطق ذات الأغلبية الكردية، فإن ذلك سيعطي مؤشر جيد للحركة السياسية الكردية وبالتحديد لحزب الاتحاد الديمقراطي للانطلاق بشكل أكبر لينطلق في الفضاء السياسي السوري.
من ناحيته لا يعتقد الباحث بمركز رامار للدراسات بدر ملا رشيد أن تتحول قسد إلى جناح سياسي بهذه السرعة، ولكنه يتوقع أن يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بحل نفسه، أو الإبقاء عليه مع التركيز على أحزاب أخرى مثل حزب سوريا المستقبل لتنخرط في العملية السياسية الوطنية السورية.
ويرى ملا رشيد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن قرار العمال الكردستاني سيسهم في دمج أو إعادة هيكلة عسكرية جديدة في لـ”قسد” ضمن وزارة الدفاع السورية، إذ ستتخلص من عبء وجود كوادر ذات نفوذ وقرار ضمن هيكليتها، مما سيعطي أريحية للحكومة السورية في التعامل مع قسد على أسس وطنية.
وكانت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا أصدرت بياناً 13 من أيار، تعليقاً على حل الحزب قالت فيه: إن مشروع عبد الله أوجلان يُعد “حلاً جذرياً” لمعضلة الشرق الأوسط.
واعتبرت أن مشروع أوجلان سيكون له تأثير ملموس على الواقع السوري عموماً، وشمال شرقي سوريا بشكل خاص، باعتباره “انطلاقة حقيقية نحو تعزيز السلام الداخلي، وترسيخ مفهوم التعايش المشترك بين مختلف المكونات”.
———————————-
ضغط سوري – تركي لتسريع تسليمها: سجون «داعش» ورقة مساومة بيد «قسد»
يشكّل ملف سجون عناصر تنظيم «داعش» ومخيمات عوائلهم، الورقة الأهم بيد «قسد» في سوريا، كونه يمسّ أمن المنطقة والإقليم، واستمرار «قوات سوريا الديمقراطية» في تسلّمه يعني استمراراً لوجودها وتثبيتاً لحكمها، بعد مرور نحو 10 سنوات على تأسيسها، ونحو 14 عاماً على تأسيس «الإدارة الذاتية» و«وحدات حماية الشعب». ولطالما لجأت «قسد» إلى إشهار هذه الورقة مع كلّ تهديد تركي، أو تلويح أميركي باحتمال الانسحاب من الأراضي السورية، وذلك للتذكير بأهمية دورها في إحلال السلم والأمن في الإقليم والعالم، خاصة بعد ما حظي به تنظيم «داعش» من سمعة دولية لجهة العمليات التي قام بها في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ومنذ الإعلان عن القضاء على التنظيم في آخر معاقله في الباغوز في ريف دير الزور الشرقي عام 2019، تسعى «قسد» لتأسيس علاقات مع دول تملك رعايا من عناصر «داعش» وعوائلهم، ما مكّن «هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» من التسويق لمشروعها في سوريا، باستغلال حالة العداء الغربي والأميركي لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وبعد سقوط الأسد أيضاً، بدأت «قسد» تؤكد أنها القوة السورية الوحيدة القادرة على تأدية مهام حماية السجون والمخيمات، نظراً إلى امتلاكها عناصر مدرّبين على هذه المهام، بإشراف من دول «التحالف الدولي»، واستنادها إلى إطراءات فرنسية وأميركية على دورها المهم كشريك موثوق في محاربة «داعش». ومع توقيع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اتفاق الـ10 آذار بينه وبينه القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، لدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية، كان أول ما طالبت به دمشق تسليمها ملف السجون والمخيمات.
وأوردت وكالة «سانا» الرسمية، بعد أقل من ساعتين على الإعلان عن الاتفاق حينها، خبراً يفيد بأن «وحدات من الأمن العام السوري تتجه إلى محافظة الحسكة لتسلم السجون والمخيمات التي تضم عناصر وعوائل تنظيم داعش الإرهابي»، وهو أمر لم يحصل حتى الآن. ولعلّ استعجال دمشق كان لإدراكها أن تلك هي الورقة الأهم التي تملكها «قسد»؛ ولذا، بدأت بالضغط على الأخيرة للشروع في إجراءات التسليم، بما يتيح إثبات قدرة دمشق على أداء المهمة نفسها، ورفع منسوب الثقة بها أمام المجتمع الدولي.
أما «قسد» فسارعت إلى نفي أي اتفاق حول حماية السجون والمخيمات، ملمّحة إلى أن هذه المهمة ستكون محصورة بقواتها لأهليتها لذلك، ولحساسية الملف بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ورفض عدد من الدول تسليم عناصر جهاديين سابقين (الأمن العام) مهام حماية سجون تضم أخطر الجهاديين في العالم، واحتمال حدوث اختراقات سيكون لها تأثير على السلم والأمن في الإقليم والعالم.
إلا أن المفاجأة التي تلقّتها «قسد» في هذا الملف، جاءت من طرف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طالب الشرع، خلال اللقاء به في الرياض، بـ«تسلّم مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا»؛ علماً أن «قسد» كانت حصلت سابقاً على تأكيدات أميركية وفرنسية، بأن ملف مراكز الاحتجاز سيبقى بيدها، إلى حين التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الحكومة السورية، وضمان تشكيل مؤسسات دولة قادرة على تأمين تلك المراكز وبالشراكة مع «الذاتية».
ولذا، بدأت «قسد» بتغيير خطابها تجاه مسألة السجون والمخيمات، من خلال تأكيد عبدي «الجاهزية للشراكة مع الحكومة السورية، للقيام بمهام حماية السجون» التي تؤوي نحو 12 ألف شخص، موزّعين على مراكز احتجاز في مدن الحسكة والشدادي والمالكية والقامشلي. وأنبأ التصريح المتقدّم بأن «قسد» تفضّل أن تتشارك مع الحكومة في حماية المعتقلات، بدلاً من تسليم الملف بالكامل إلى دمشق، وذلك بالاستناد إلى خبرة من ستّ سنوات لم يتخلّلها اختراق، باستثناء الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتؤكد مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «ملف سجون ومخيمات داعش لا يزال محط نقاش بين المسؤولين الأميركيين والأتراك، مع عرض الأخيرين تقديم الدعم للحكومة السورية لتمكينها من تأدية هذه المهمة»، مشيرة إلى أن «أنقرة تريد أن تسحب تلك الورقة من يد قسد بهدف إضعافها». وتضيف المصادر أن «قسد لا ترغب في الاستغناء عن هذا الملف لصالح دمشق، لإدراكها أن ذلك سيكون مدخلاً لانسحاب أميركي كامل من سوريا، من دون تمكّنها من تحقيق مكاسب سياسية»، لافتة إلى أن «فرنسا تضغط نحو الحفاظ على قسد كشريك موثوق في محاربة داعش».
وتتوقّع المصادر أن «تتمّ دراسة خيار نقل المسلّحين السوريين إلى سجون في حلب أو محافظات أخرى تحت سيطرة الحكومة»، مرجّحة أن «يبقى المقاتلون الأجانب في سجون قسد وبإشراف أميركي – فرنسي، إلى حين اتضاح قدرة دمشق على تلبية الشروط الأميركية والغربية للتطبيع الشامل معها، بعد منحها فرصة لتغيير سلوكها، من خلال قرار أميركي – أوروبي برفع العقوبات
عنها».
————————————–
انقسام داخل “قسد” يهدد التفاهم مع دمشق.. وتركيا “تراقب عن كثب“
2025.05.22
في تصعيد لافت، هاجم آلدار خليل المعروف بـ” مهندس الإدارة الذاتية” ما سماها “مركزية دمشق” محذرا من خطر “تقسيم البلاد”، ودعا إلى تعديل الدستور والاعتراف بالقضية الكردية. ورفض أي “إملاءات تركية” بشأن سلاح “قسد”، مؤكدا الانفتاح على الحوار من “موقع القوة”.
التصريحات تأتي وسط انقسامات داخلية وضغوط من “PKK” على مظلوم عبدي لعرقلة الاتفاق مع دمشق بحسب ما كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، في حين أكدت أنقرة أنها تتابع تنفيذ الاتفاق “عن كثب”.
وقال آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، إن قرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه أوجد أساساً لتغيير سياسات تركيا وخفض التصعيد تجاه شمال شرقي سوريا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا “التطور يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستقرار في المنطقة إذا تجاوبت أنقرة معه”.
انتقاد “مركزية” دمشق
واتهم خليل الحكومة السورية بالإصرار على النهج المركزي، محذرا من أن هذه السياسة ستؤدي إلى “تقسيم سوريا وستدفع بالبلاد إلى حرب أهلية”، مؤكدًا أن الحل الوحيد يمر عبر الاعتراف بالتنوع السياسي والإداري القائم على الأرض.
وأشار خليل خلال مقابلة مع فضائية “كردسات نيوز”، الخميس، إلى أن وفد التفاوض مع حكومة دمشق سيكون ممثلًا عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، موضحًا أن الوفد الكردي سيكون جزءًا من هذا الفريق، وأن أجندة الحوار ستركّز على تعديل دستور سوريا والتوافق عليه، إضافة إلى الاعتراف بالقضية الكردية وتحديد طبيعة نظام الحكم وطبيعة الجيش في البلاد.
وأكد رفض “الإدارة الذاتية” لسياسات الحكومة السورية الحالية تجاه مكونات مثل العلويين والدروز، مشددًا على أن الوفد التفاوضي سيناقش حقوق جميع المكونات السورية من دون تهميش، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة.
وشدد خليل على أن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية مع حكومة الشرع، مؤكداً أن هذا الانفتاح يأتي من موقع “القوة وليس الضعف”.
وقال إن “قسد” ووحدات حماية الشعب ليست امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، مشيرًا إلى أن مستقبل هذه القوات سيناقش مع دمشق، وشدد على أنه “لن نقبل بأي إملاءات تركية بخصوص نزع السلاح”، حسب تعبيره.
وأكد خليل، أن التحالف الدولي والإدارة الأميركية لم تخطرا الإدارة الذاتية أو “قسد” بأي قرار بشأن تسليم ملف تنظيم الدولة (داعش) إلى الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الملف من دون “قسد” غير ممكنة، وأن الغرب يدرك العواقب المحتملة لذلك، خاصة مع وجود حالة عدم ثقة بقدرات دمشق، زاعما وجود فصائل ضمن الجيش السوري كانت في وقت سابق تنتمي “لداعش”.
وختم خليل بالقول إن الكُرد يمتلكون قيادة سياسية وعسكرية وتجربة طويلة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنهم “لن يكونوا في سطور لوزان جديدة”.
تعطيل الاتفاق مع الحكومة السورية.. ضغوط من “PKK” على قسد
كشف مصدر مطلع ومقرّب من “قسد” لموقع تلفزيون سوريا أن مسؤولي حزب العمال الكردستاني يضغطون على قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بهدف التماطل في تنفيذ بنود الاتفاق مع الحكومة السورية.
وأشار المصدر إلى أن “رفض قسد الانسحاب من سد تشرين، والاستمرار في تنفيذ خطوات الاتفاق مع الحكومة السورية بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، جاء بضغوط من قادة عسكريين موالين لحزب العمال الكردستاني”.
وأكد المصدر أن “قادة عسكريين من حزب العمال الكردستاني أشرفوا على عملية تسلل وتقدّم نحو نقاط القوات السورية في محيط سد تشرين قبل عدة أيام، ما تسبب باندلاع اشتباكات محدودة، قبل أن تنسحب عناصر قسد إلى مواقعها بأوامر من عبدي، الذي سعى إلى التهدئة ومنع اتساع الاشتباكات”.
وربط المصدر التصريحات الأخيرة لآلدار خليل بحالة الانقسام والتباين بين موقف وتوجّه مظلوم عبدي، المقرّب من واشنطن، وخليل، أحد أبرز قادة التيار المتشدد الموالي لحزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا.
أردوغان: تركيا تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق
وفي السياق كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تشكيل تركيا مع الأميركيين وإدارتي دمشق وبغداد لجنة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم “داعش” وعائلاتهم في المخيمات التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرقي سوريا.
وأضاف: “من ناحية أخرى هل ستستجيب (واي بي جي) للدعوة الموجهة في تركيا؟ أم أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس/ آذار، الذي تم التوصل إليه في دمشق؟ أم أنها ستفعل الأمرين معا؟”.
وشدد أردوغان، على أن “عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع سلاحه يشمل أيضا ذراع التنظيم في سوريا (في إشارة إلى قسد). ونعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من آذار تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران”.
وشدد على أن تركيا تتابع مسألة “قسد” في شمال سوريا عن كثب، مؤكدا أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية.
وأشار أردوغان، إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبرا أن الأيام المقبلة “حاسمة للغاية” في هذا الصدد.
وأردف: “يحتاج العراق إلى التركيز على قضية المخيمات. أغلب النساء والأطفال، وخاصة في مخيم الهول، هم من العراق وسوريا. يجب عليهم أن يأخذوا دورهم. ومع حل هذه المشاكل فإن أهمية (واي بي جي) ستتضاءل وسيسهل اندماجها”.
على طاولة دمشق.. سجون “داعش” ودمج “قسد” في الجيش السوري
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.
وجاءت هذه الزيارة في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.
وخلال المحادثات، ناقش كالن عدداً من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة “داعش” في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.
وبحسب ما نقلته قناة (CNN Türk) أمس، عن مراسلها أردا أردوغان، كان العنوان الأبرز في الزيارة هو ملف السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم الدولة “داعش”، والتي تُعرف بأنها تخضع بمعظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأوضحت القناة أن الجانبين بحثا “الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة”، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.
تلفزيون سوريا
————————
إردوغان: على دمشق التركيز على اتفاقها مع «قسد»
22 مايو 2025 م
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، إنه يتعين على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه.
وفي حديثه إلى صحافيين على متن طائرة من بودابست، قال إردوغان إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في معسكرات الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تديرها «قسد» منذ سنوات.
———————–
أردوغان: تفكيك “PKK” يشمل سوريا وعلى دمشق التركيز بتنفيذ اتفاقها مع “قسد“
2025.05.22
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رفع العقوبات عن سوريا تعتبر “خطوة بالغة الأهمية” لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أردوغان، في تصريحات بالطائرة خلال عودته من زيارة المجر، أن رفع العقوبات عن سوريا “يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البناءة عن نتائج”.
وأشار إلى أنه خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ركزا إلى مسألة رفع العقوبات عن سوريا.
ولفت الرئيس أردوغان، إلى تشكيل تركيا مع الأميركيين وإدارتي دمشق وبغداد لجنة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم “داعش” وعائلاتهم في المخيمات التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرقي سوريا.
وأضاف: “من ناحية أخرى هل ستستجيب (واي بي جي) للدعوة الموجهة في تركيا؟ أم أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس/ آذار، الذي تم التوصل إليه في دمشق؟ أم أنها ستفعل الأمرين معا؟”
وشدد أردوغان، على أن “عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع سلاحه يشمل أيضا ذراع التنظيم في سوريا (في إشارة إلى قسد). ونعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران”.
وشدد على أن تركيا تتابع مسألة “قسد” في شمال سوريا عن كثب، مؤكدا أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية.
وأشار أردوغان، إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبرا أن الأيام المقبلة “حاسمة للغاية” في هذا الصدد.
وأردف: “يحتاج العراق إلى التركيز على قضية المخيمات. أغلب النساء والأطفال، وخاصة في مخيم الهول، هم من العراق وسوريا. يجب عليهم أن يأخذوا دورهم. ومع حل هذه المشاكل فإن أهمية (واي بي جي) ستتضاءل وسيسهل اندماجها”.
كما لفت أردوغان، إلى أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بنفس الشكل.
على طاولة دمشق.. سجون “داعش” ودمج “قسد” في الجيش السوري
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.
وجاءت هذه الزيارة في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن في العاصمة دمشق (الأناضول)
سجون “داعش” ودمج “قسد” في الجيش.. إعلام تركي يكشف تفاصيل زيارة كالن إلى دمشق
وخلال المحادثات، ناقش كالن عدداً من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة “داعش” في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.
وبحسب ما نقلته قناة (CNN Türk) أمس، عن مراسلها أردا أردوغان، كان العنوان الأبرز في الزيارة هو ملف السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم الدولة “داعش”، والتي تُعرف بأنها تخضع بمعظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأوضحت القناة أن الجانبين بحثا “الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة”، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.
——————————-
آلدار خليل يصعّد: نرفض إملاءات تركيا ومركزية دمشق تهدد بتقسيم سوريا
2025.05.22
قال آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، إن قرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه أوجد أساساً لتغيير سياسات تركيا وخفض التصعيد تجاه شمال شرقي سوريا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا “التطور يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستقرار في المنطقة إذا تجاوبت أنقرة معه”.
انتقاد “مركزية” دمشق
واتهم خليل الحكومة السورية بالإصرار على النهج المركزي، محذرا من أن هذه السياسة ستؤدي إلى “تقسيم سوريا وستدفع بالبلاد إلى حرب أهلية”، مؤكدًا أن الحل الوحيد يمر عبر الاعتراف بالتنوع السياسي والإداري القائم على الأرض.
وأشار خليل خلال مقابلة مع فضائية “كردسات نيوز”، الخميس، إلى أن وفد التفاوض مع حكومة دمشق سيكون ممثلًا عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، موضحًا أن الوفد الكردي سيكون جزءًا من هذا الفريق، وأن أجندة الحوار ستركّز على تعديل دستور سوريا والتوافق عليه، إضافة إلى الاعتراف بالقضية الكردية وتحديد طبيعة نظام الحكم وطبيعة الجيش في البلاد.
أردوغان: تفكيك “PKK” يشمل سوريا وعلى دمشق التركيز بتنفيذ اتفاقها مع “قسد”
وأكد رفض “الإدارة الذاتية” لسياسات الحكومة السورية الحالية تجاه مكونات مثل العلويين والدروز، مشددًا على أن الوفد التفاوضي سيناقش حقوق جميع المكونات السورية من دون تهميش، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة.
وشدد خليل على أن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية مع حكومة الشرع، مؤكداً أن هذا الانفتاح يأتي من موقع “القوة وليس الضعف”.
وقال إن “قسد” ووحدات حماية الشعب ليست امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، مشيرًا إلى أن مستقبل هذه القوات سيناقش مع دمشق، وشدد على أنه “لن نقبل بأي إملاءات تركية بخصوص نزع السلاح”، حسب تعبيره.
ملف “داعش” شمال شرقي سوريا
وأكد خليل، أن التحالف الدولي والإدارة الأميركية لم تخطرا الإدارة الذاتية أو “قسد” بأي قرار بشأن تسليم ملف تنظيم الدولة (داعش) إلى الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الملف من دون “قسد” غير ممكنة، وأن الغرب يدرك العواقب المحتملة لذلك، خاصة مع وجود حالة عدم ثقة بقدرات دمشق، زاعما وجود فصائل ضمن الجيش السوري كانت في وقت سابق تنتمي “لداعش”.
وختم خليل بالقول إن الكُرد يمتلكون قيادة سياسية وعسكرية وتجربة طويلة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنهم “لن يكونوا في سطور لوزان جديدة”.
وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا والولايات المتحدة وسوريا والعراق، شكّلت لجنة رباعية لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم الدولة “داعش”، المحتجزين في معسكرات الاحتجاز شمال شرقي سوريا.
وأكد أردوغان أن تركيا تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مشددا على ضرورة أن تركز الإدارة السورية، على الاتفاق مع “قسد” باعتباره خطوة أساسية لمعالجة ملف عناصر التنظيم المحتجزين. وفق وكالة الأناضول.
ودعا الرئيس التركي في تصريحات بالطائرة خلال عودته من زيارة المجر، العراق إلى تحمّل مسؤولياته في هذا الملف، لافتا إلى أن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين، ويجب إعادة العراقيين إلى بلادهم.
——————————
في مساعٍ للحكم الذاتي.. الأحزاب الكردية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً
2025.05.23
أعلن ألدار خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق قريباً، لإجراء محادثات بشأن المستقبل السياسي لمناطق شمال شرقي سوريا، وذلك “في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على إدارة ذاتية”.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، قال خليل إن “وثيقة الرؤية الكردية ستكون أساساً للمفاوضات مع دمشق”، مضيفاً أنه “قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً”.
وتأتي تصريحات خليل وسط انقسامات داخلية وضغوط يمارسها حزب “العمال الكردستاني” على قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، لعرقلة الاتفاق مع دمشق بحسب ما كشفت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” في وقت سابق.
“موقف متصلب” ورغبة في “الحوار والمشاركة”
وقال خليل إن موقف الحكومة السورية “لا يزال متصلباً”، لكنه شدد على رغبة الجانب الكردي في “الحوار والمشاركة”، محذراً من أن أي نقاش حول قضية السلاح سيكون “عقيماً” إذا لم يتم ضمان أمن المنطقة “دستورياً وسياسياً”.
وأضاف أن دور قوات الأمن التي يقودها الأكراد هو ضمان “أمن وسلامة المنطقة”، مؤكداً أنه “إذا لم يتم ضمان ذلك دستورياً وقانونياً وسياسياً، فإن مناقشة قضية الأسلحة ستكون عقيمة”.
واعتبر خليل أن الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية حالياً “أحادية الجانب”، داعياً إلى مسار تشاركي لحل الخلافات.
وأوضح خليل أن إعلان حزب “العمال الكردستاني” حلّ نفسه ووقف الصراع المسلح مع تركيا من شأنه أن يزيل الذرائع التي تعتمدها أنقرة لمهاجمة شمال شرقي سوريا. وقال: “لن يكون هناك مبرر لتركيا لمهاجمة المنطقة”.
سياق متأزم و”رؤية كردية”
ويأتي ذلك في سياق اتفاق تم توقيعه، في آذار الماضي، لدمج المؤسسات الأمنية والمدنية شمال شرقي سوريا ضمن هيكليات الدولة السورية، غير أن التنفيذ لا يزال محدوداً بسبب التباينات السياسية والضغوط الإقليمية.
وبرزت قضية الحكم الذاتي كأحد أبرز المطالب الكردية، في حين تعارض الحكومة السورية هذه المطالب، وسبق أن رفضت، في بيان رسمي، أي خطوة “تفرض التقسيم أو تنشئ كانتونات انفصالية”.
وفي نيسان الماضي، أصدرت القوى الكردية المتنافسة رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة إدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف الحفاظ على مكتسبات ما بعد الحرب.
تلفزيون سوريا
——————————
=====================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 23 ايار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
————————————-
=
الفصائل المسلحة في السويداء بين صراع الوطنية ورهانات السلاح/ مهيب الرفاعي
الجمعة 2025/05/23
لعب الدروز دوراً مهماً في بناء الدولة السورية، لكنهم تعرضوا للتهميش بعد انقلاب عام 1963 وما تبعه من تصفيات داخلية، خاصة مع رفضهم الانخراط في الخط البعثي، وارتباطهم بدروز لبنان المعارضين لتدخل الأسد. وقد زادت القطيعة مع النظام بعد اغتيال قيادات درزية بارزة ككمال جنبلاط، ما أدى إلى استبعادهم من مراكز القرار في الحزب والجيش والأمن، باستثناءات نادرة مثل عصام وأسامة زهر الدين، الضابطين في المخابرات العسكرية.
هذا التهميش عمّق شعورهم بالغبن، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في محافظة السويداء. وعام 2022، انطلقت احتجاجات سلمية في السويداء عبّرت عن رفض الفساد وغياب الدولة، ورفعت شعارات الثورة السورية، مطالبة بتنفيذ القرار 2254، والكشف عن مصير المعتقلين، وخروج القوات الروسية والإيرانية. ورغم تشويه نظام الأسد لهذا الحراك والحملة الإعلامية ضده، تميز الحراك بطابعه المدني، وشارك فيه شباب ونساء وزعامات دينية، مع تنسيق واضح مع درعا؛ وحاول نظام الأسد احتواءه دون استخدام العنف المفرط، عبر ضغوط واتصالات محلية؛ في الوقت الذي ظهرت فصائل محلية مثل “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” لحماية المجتمع والحراك من الأمن والفوضى، ورفض أي تطرف أو تبعية.
نحو مشروع وطني جامع
بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، سعت الإدارة الجديدة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة في السويداء مع وجود رغبة وإرادة سياسية حقيقية، تُعيد للدروز مكانتهم التاريخية، وتُحقق تطلعاتهم في العدالة والمساواة واحترام تنوع البلاد، والاستفادة من إرثهم النضالي ومثقفيهم. ومنذ الأسابيع الأولى، دعت الإدارة الجديدة إلى دمج الفصائل المحلية في مؤسسات الدولة من خلال برامج تأهيل وتدريب لضمان ولائها، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار؛ كما دعت إلى تعزيز دور القضاء المحلي وتفعيل الضابطة العدلية بإشراف شخصيات موثوقة من أبناء المحافظة لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتوازى مع إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف المعنية.
شهد المشهد العسكري في السويداء بعدها تنوعاً لافتاً في الفصائل المسلحة من حيث التكوين والانتماء والرؤى السياسية والأمنية، وهو تنوع ناتج عن التحولات الداخلية والإقليمية، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية بشأن “حماية الدروز”. ويمكن تصنيف هذه الفصائل إلى تيارين رئيسيين: الأول هو الفصائل التقليدية ذات التوجه المعتدل، مثل “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” و”تجمع أحرار الجبل”، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المرجعيات الدينية التقليدية وتؤدي دوراً محلياً في حماية أمن الجبل دون انخراط في مشاريع انفصالية أو فيدرالية، مع إبقاء مسافة محسوبة من السلطة الجديدة التي تقبل بها بشروط تحفظ استقلالية القرار المحلي.
أما التيار الثاني فيتمثل في الفصائل الراديكالية حديثة التشكيل، مثل “قوات العليا” و”سرايا الجبل” و”شيخ الكرامة”، والتي تتبنى مواقف الشيخ حكمت الهجري وتطرح مشاريع سياسية أكثر طموحاً، تدعو إلى نظام فيدرالي وترفض السلطة الجديدة بشكل قاطع، كما تسعى إلى توحيد العمل العسكري ضمن هيكل مؤسساتي يحقق التمثيل السياسي لمحافظة السويداء.
فصيل ثالث
ورغم التباينات الجوهرية بين هذين التيارين، فإن كليهما يتفق على أولوية الدفاع عن السويداء ورفض أي تهديد خارجي، خصوصاً من الجماعات المتطرفة أو التدخلات الإقليمية. وفي موازاة ذلك، يبرز فصيل ثالث مغاير من حيث الهوية والانتماء، يتمثل في “تجمع عشائر السنة” من البدو وعشائر السنة المقيمين في السويداء، وهو داعم صريح للسلطة الجديدة ويتميّز بقربه منها مقارنة بالفصائل الدرزية. ويعكس هذا التعدد الفصائلي توتراً عميقاً بين الهوية الوطنية والخصوصية الطائفية، وبين المركزية واللامركزية، ويكشف عن مشهد غير متجانس تتحكم فيه المرجعيات الدينية والانتماءات السياسية والمواقف من القضايا الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها العلاقة مع إسرائيل والإدارة الذاتية.
التوترات الأمنية وشبح العسكرة
ومع تصاعد التوترات الأمنية في السويداء، وتعدد الفصائل والولاءات، واتساع دائرة المزايدات بالوطنية والانتماء، ودخول العشائر على الخط عبر مناوشات مع فصائل محلية في المدينة والقرى المحيطة، كان لا بد من إفساح المجال لرجال الدين والمسؤولين الأمنيين المحليين ليكونوا مرجعيات معنوية وعملية في أوقات حرجة، لا سيما وأن الحكومة السورية الجديدة تركز على محافظة السويداء لترتيب أوراقها وتصحيح مسار التعامل معها عمّا كان عليه نظام الأسد، مع تقديم ضمانات حقيقية عبر الممثل الحكومي (المحافظ) فيها، من خلال اجتماعاته مع الوجهاء ورجال الدين.
ويبرز دور المشيخة في ضبط السلم الأهلي عبر تهدئة التوترات الداخلية، ودرء الاقتتال بين الفصائل المحلية المعارضة للحكومة الجديدة والموالية لها. كما كانت طرفاً مقبولاً لدى الأهالي للتفاوض مع الدولة الجديدة من خلال منع الانزلاق نحو الحرب الأهلية داخل السويداء ودعم الاحتجاجات السلمية والوقوف بوجه العصابات والفلتان الأمني الذي حصل في الأسابيع الأولى من التحرير ولو عبر وساطات معنوي وأهلية. ولم تكن مشيخة العقل داعمة لحمل السلاح خارج الدولة بشكل دائم، لكنها في الوقت نفسه تفهمت الأسباب التي دفعت الفصائل للتسلح، مثل غياب الأمن وعمليات الخطف وتفشي الجريمة. لذا كانت دعوات المشيخة دائماً تدور حول حصر السلاح بيد الدولة، لكن بعد إصلاح أجهزتها وتفكيك العصابات الإجرامية المرتبطة ببعض المليشيات المحلية التي لربما يكون لها ارتباطات خارجية مع التأكيد على إعادة بناء ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.
تعزز هذه التوصيات موقع المشيخة الدينية في عملية السلم الأهلي وخلق مناخ آمن لتفعيل دور العدالة الانتقالية، كونها تؤكد على ترسيخ موقع المشيخة كمؤسسة وطنية لا طائفية، تعبر عن الدروز كمكون وطني، لا ككيان منفصل؛ مع إشراك المشيخة في جهود المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي.
تغيرات تجاه الفصائل المسلحة
من خلال البيان الصادر عقب اجتماع المشايخ مع محافظ السويداء، يبدو أنهم قد حسموا موقفهم بوضوح تجاه مسألة السلاح والفصائل المسلحة التي أصبحت تشكل تهديداً واضحاً لسيادة الدولة وممثليها في المحافظة، لا سيما بعد الاعتداءات المتكررة من قبل أفراد ومليشيات منفلتة على مبنى الأمن الجنائي ومبنى المحافظة وصولاً إلى الاعتداء على مكتب المحافظ شخصياً. فقد أبدوا قلقاً واضحاً من حالة الفوضى التي نجمت عن تجاوزات بعض الأفراد بحق الضابطة العدلية وعناصر الشرطة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ خطوة لافتة بتفويض الفصائل المحلية والأهلية بدعم مهام هذه المؤسسات، لا بهدف فرض واقع مليشياتي، بل في محاولة لضبط السلاح وتوجيهه نحو حماية القانون وهيبة الدولة.
ومن خلال دعوة المشيخة العلنية لجميع الفصائل بالتعاون الكامل مع الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية، هناك نية جدية لتحويل الفصائل من قوى خارجة عن القانون إلى شركاء في حفظه، ضمن أطر واضحة تحترم المؤسسات القضائية والشرطية. والأهم من ذلك، أن المشيخة لم تكتفِ بالدعوة، بل أطلقت تحذيراً واضحاً من أي اعتداء على هذه الأجهزة أو على أفرادها، في خطوة تُظهر تحولاً نوعياً في الخطاب والموقف تجاه منطق الفوضى والسلاح المنفلت.
في المقابل، يظهر أن المشيخة لا تتعامل مع الفصائل وحدها، بل توجه أيضاً خطاباً مباشراً لعناصر الشرطة من أبناء المحافظة، تدعوهم فيه لاستعادة دورهم على الأرض بفعالية وجدية، رغم المقومات اللوجستية الضعيفة، لا سيما وأنهم يدركون أن أي نجاح في فرض القانون لا يمكن أن يتحقق دون عودة المؤسسات الرسمية للقيام بمهامها، وهو ما يجعل موقف المشيخة أقرب إلى رسم معادلة جديدة قائمة على فكرة أن السلاح يجب أن يُضبط، والفصائل يجب أن تتحول من أدوات نزاع إلى أدوات دعم، والقانون هو المرجعية الأولى للجميع.
يعكس هذا الطرح توجهاً جديداً يسعى إلى كبح العشوائية وتنظيم دور القوى الأهلية ضمن مظلة القانون، بما يشير إلى وعي متزايد بأن الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا بتكامل الأدوار بين المجتمع المحلي ومؤسساته الرسمية.
دفع هذا التغير حركة “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” إلى إعادة الانتشار في المحافظة، تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون ووضع حد للسلاح المنفلت الذي يهدد السلم الأهلي في السويداء.
المدن
——————————
الطائفية والاستراتيجية الإسرائيلية.. تفكيك سوريا/ عبد الله مكسور
2025.05.22
عندما ينكفئ النظام الدولي عن قيمه، ويُسلم زمام القيادة لمنطق الغلبة لا العدالة، تبدأ خارطة العالم بالاهتزاز على وقع هويات ضيقة، وتُصبح الطائفية والانتماءات الضيقة أداة لإعادة رسم الجغرافيا وحدود الاشتباك.
فالهوية حين تُختزل إلى ذاكرة جريحة، تصبح سلاحاً في يد من يعرف كيف يوظفها. في الحالة السورية، لم تعد إسرائيل مضطرة لإظهار أنيابها في اجتياحات تقليدية، فحضورها لم يعد عسكرياً ثابتاً ومباشراً، بل ناعماً، مراوغاً، متسللاً عبر التشققات الطائفية، ومن خلال فراغ الدولة التي تحاول تدريجياً استعادة المشروع الجامع والتمثيل الوطني. وفي مثل هذا السياق المتداعي، لا تعود الطائفية مجرّد انحراف اجتماعي أو أثر جانبي لتاريخ من الانقسامات أو الأزمات أو حتى الحرب الأهلية.
بيع الوهم الإسرائيلي
لم تعد تل أبيب بحاجة إلى أن تُقنع العالم “بمخاوفها” من جبهة جنوبية نشطة سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، بل يكفيها أن ترى “الوطن السوري” يتحول إلى فسيفساء مفككة، تتصارع فيها الكيانات على سلطة محلية خالية من الجوهر الوطني، وتنهض فيها الطوائف كملاذ للخوف لا كمكون منسجم ضمن كيان واحد. مدركةً تماماً أنه عندما يُفقد الإحساس بالانتماء الأوسع، يصبح صوت الجماعة الصغيرة أقرب إلى صراخ النجاة وطلب النجدة، بهذا الصراخ تتغذى الاستراتيجيات الإسرائيلية، فيُصاغ التدخل لا على هيئة صاروخ أو طائرة، بل على هيئة رعاية للمخاوف، ودعم للمظلوميات، ووعود بالحماية. وهكذا تُستثمر الطائفية لا بوصفها حتمية تاريخية، بل باعتبارها موردًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، يُعاد إنتاجه إسرائيلياً بلا كلل. فكلما تصادمت الطوائف، تقدّمت إسرائيل خطوة إضافية في مشروعها.
في الحالة السورية، تتجلى هذه المعادلة بوضوح حاد. إذ لم تعد إسرائيل، وهي أحد أبرز المستفيدين من هذا التفتت الإقليمي، في حاجة إلى حروب شاملة أو اجتياحات برية كما فعلت في بيروت عام 1982. بل تدخل من نوافذ الهوية المذعورة في لحظة تاريخية مضطربة بالنسبة لسوريا. تدرك تل أبيب، أن البيئة الأمنية التي تتيح لها لعب دور “الحامي من الخوف” هي أكثر نجاعة من أي احتلال عسكري قد ينهار أمام مقاومة أو متغير دولي. لذلك تسعى لخلق ظروف تجعل من التدخل المستدام ضرورة محلية قبل أن يكون قراراً خارجياً. إنها تفعل ذلك باسم “الحماية”، بينما جوهره يقوم على هندسة التفكيك الناعم، الذي يُبقيها حاضرة في الجغرافيا دون أن تظهر في الخرائط الرسمية. فنكون جميعاً في خريطة دولة تتفكك إلى كيانات رخوة، تتوزعها الولاءات المذهبية والمناطقية، وتفتقر إلى أي مشروع وطني جامع أو سردية وطنية قابلة للتوحيد. إسرائيل تدرك أن الدول لا تسقط فقط عبر الحرب، بل قد تسقط عبر “الهندسة الهادئة للهويات”، وهي تُتقن فنون هذه الهندسة.
إنها اللحظة الإسرائيلية المثالية، التي لا تحتاج فيها إلى الدبابات بل إلى خرائط تُعاد حضورها بهدوء فوق هشيم من الثقة الوطنية المتهالكة. “التفكك المستدام”، ذاك المفهوم الذي تحوّل من تكتيك إلى استراتيجية، هو الغاية التي تتطلع إليها إسرائيل في الحالة السورية: تفكيك الانتماء قبل الحدود، تفتيت الرؤية الجامعة قبل الجغرافيا، وترسيخ منطق الطائفة بوصفها الملاذ الأخير. في ظل هذا المشهد، يحضر تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المولود في الجولان السوري المحتل، كدليل واضح على هذا المنطق حين قال بوقاحة سياسية: “نهاية ما يحدث في سوريا هو أن تصبح دولة مفتّتة، ضعيفة، مجزّأة.” هذا التصريح لا يُقرأ بوصفه موقفاً عابراً، بل يعكس ما يمكن تسميته بالعقيدة الأمنية–الاستراتيجية لدى الدولة العبرية، ومفادة أن إسرائيل إسرائيل إلى القضاء على الدولة السورية، بل إلى إبقائها في حالة “اللا دولة”، لا قوية ولا موحدة، بل كيان مُعلّق بين الوجود والعدم. وفي هذا المسار، يتجلى ما يمكن وضعه في خانة رؤية الأمن القومي الإسرائيلي استراتيجياً: سوريا لا يُفترض أن تعود كيانًا موحدًا، بل يجب أن تبقى “معلّقة” بين الوجود واللاوجود، بين الدولة واللادولة، بحيث تتحوّل إلى حقل رملي من الهويات المنفصلة، يسهل إدارة صراعاتها، ولا يمكن لمخيلتها الوطنية أن تنهض من بين الركام.
تفكيك العصب الوطني
هذا لا يتحقق باجتياح عسكري أو باحتلال مباشر، تدرك إسرائيل أن أقوى أشكال التفتيت ليست تلك التي تحدث عبر الحرب، بل عبر إعادة تشكيل المخيال العام. من خلال سياسة “تفكيك العصب الوطني”. يتم ذلك عبر إعادة تعريف سوريا ليس ككيان سياسي، بل كـ”حيّز طائفي” يتنازع فيه الزعماء المحليون على تمثيل طوائفهم، لا على تمثيل الدولة. وبهذا المعنى، تصبح الجغرافيا قابلة لإعادة التشكيل، لا بالدماء وحدها، بل بالعقول والمخاوف والتمويل. ويُعاد إنتاج الخارطة، ليس وفق السيادة، بل وفق الهوية الضيقة، فتنهار فكرة الكيان الجامع، حتى لو بقيت العاصمة تحت علم الجمهورية. فالجماعة التي تتبنى الطائفية فقدت الثقة في فكرة الوطن، وتحولت ذاكرتها إلى أرشيف للمظلومية، وهذا ما يُنضِج ظروف التقسيم من الداخل. فعندما تنهار الرواية الكبرى، يخرج كل واحد من كهفه شاهراً سيفه أو عصاه دفاعاً عن روايته، هذا هو جوهر اللعبة الإسرائيلية: سحب الغطاء عن الرواية الجامعة، وترك الجميع يتصارعون على الخوف. من هنا تصبح الطوائف ليست فقط أداة للتمايز، بل وحدة هندسية جديدة تُرسم بها خرائط النفوذ. الطائفة، حين تُسلخ عن بعدها الثقافي والديني وتُختزل في سعي بعض أعضائها إلى تحويلها لهوية سياسية مهما كان الثمن، تتحول إلى وحدة قياس تستخدمها قوى الخارج لتحديد مصالحها. وفي هذا المربع تتفوّق إسرائيل على خصومها؛ لأنها لم تعد تحارب بالطائرات بل بالأفكار، لا تبني مستوطنات فقط، بل تبني ذهنيات ملوثة بالخوف والانعزال.
الخوف والانعزال المبني على المظلومية، والذاكرة المجتزأة، والانتماء المغلق كملاذ خوف، فإن هذا التكوين يُصبح منجمًا سياسيًا لا يُهدر. ومن خلاله، تُعاد صياغة القيمة المعيارية للوطن السوري بحيث يصبح خليطًا من الهويات الجزئية، تتحرك كل واحدة منها تحت وطأة التهديد المتخيل والمزعوم من الأخرى، وتبحث عن حماية لا في الدولة، بل في الخارج، حيث تقدّم إسرائيل نفسها، إلى جانب قوى إقليمية أخرى، كضامن “موثوق”. وهنا يتبدى جوهر التحول: لم تعد الطائفة إطارًا ثقافيًا أو دينيًا، بل تحولت إلى “وحدة سياسية قابلة للإدارة”، وإلى عنصر في معادلة إقليمية يُعاد من خلالها تعريف السيادة.
صناعة الطائفية
لا بد أن يدرك السوريون والسوريات أن الخطر لا يكمن في وجود الطوائف، بل في تحوّلها إلى نظام إدارة. كما جاء في أحد الأمثال الإسرائيلية: “حين يتقاتل الجيران، تبني إسرائيل السياج وتفتح بوابة خلفية لكل منهم”. إنها لا تصنع الطائفية من عدم، لكنها ترعاها بصبر سياسي طويل. لا تطلق شرارتها الأولى، لكنها تغذيها بالخوف والتمييز والتضليل. كل طائفة تُقدَّم لها إسرائيل باعتبارها الحامية من الأخرى، والشريك المحتمل، وحتى المُخلص من الفوضى. وهنا، يتداخل الأمني مع الإنساني، والسياسي مع الطائفي. فتُمنح الطوائف مساعدات “إنسانية”، وتُعالج جراحها في مستشفيات مموّلة، وتُدعم فصائلها المسلحة بذكاء ناعم، لا لتحقق نصراً، بل لتتوازن ضمن معادلة هشّة. وتصبح الخرائط الطائفية هي الأرضية الجديدة التي تبني عليها إسرائيل مشروعها في “الهلال الهشّ”، فكلما ازداد الانقسام، ازدادت القدرة على التدخل، ليس فقط جغرافيًا، بل بنيويًا ونفسيًا وثقافيًا.
لقد انتقلت العقيدة الإسرائيلية من منطق الاحتلال الكلاسيكي إلى ما يمكن تسميته بـ”الهيمنة الرمادية”، التي لا تُظهر وجهها القاسي، بل تختبئ خلف واجهات متعددة: حماية الأقليات، ومواجهة إيران، ودعم الاستقرار. وهي بذلك، تقدم خطابًا مزدوجًا: للداخل الإسرائيلي المضطرب، بأنها تحقق أهدافها من دون خسائر بشرية كبرى؛ وللخارج، بأنها شريك استقرار في منطقة مأزومة. لهذا نراها تطرح مشاريع من شاكلة “ممر داوود الاستراتيجي”/” ربط البحر الميت بالبحر الأحمر”. لا كخطط اقتصادية فحسب، بل كتحركات هندسية أمنية تحت غطاء التوازن المائي والجغرافي، وخلق عوازل بالمعنى العسكري قابلة للتوظيف لاحقًا في أي صراع. ويُعاد إحياء مخططات قديمة من أرشيف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تراهن على إدارة منطقة مفككة تقوم على الكانتونات، لا على الدول، وعلى التحالفات الوظيفية لا السيادة.
إنها عودة إلى منطق شمعون بيريز حين قال: “الشرق الأوسط الجديد لا يُبنى بالجيوش، بل بالشبكات”، لكنه هذه المرة يُبنى بشبكات الطوائف، لا شبكات التكنولوجيا. أما الطائفية، فهي هنا ليست انتماءً روحياً أو شعورًا دينيًا، بل منظومة إدارة، ونموذج تقسيم، وآلية لضمان استمرار العجز السياسي. مظلومية تُسندها ذاكرة موجّهة، وخوف متبادل يُكرّس الانفصال الوظيفي بين المكوّنات. وكلما طال هذا الانفصال، تأجلت أي فرصة لبناء مشروع وطني سوري متماسك. فتبدو إسرائيل أقل كقوة احتلال، وأكثر كمحور توازن. وتُعاد صياغة مفهوم “الحماية” ليتحوّل من الدولة إلى الخارج، ومن الجيش إلى “الضامن الإقليمي”. وتُخاض الحروب، لا من أجل توحيد البلاد، بل من أجل ضمان استقرار التفكك.
والنتيجة في كل هذا انهيار الدولة في مضمونها، لا في مؤسساتها الشكلية. أما الأخطر من الانهيار، فهو إعادة تعريف سوريا كحيّز طائفي غير قابل للحكم من الداخل، لكنه قابل للإدارة من الخارج. إنه نوع من الاستعمار الناعم الذي لا يرفع الرايات، بل يعيد ترسيم الوعي. يهمّش الوطنية لصالح المذهبية، ويستعيض عن السيادة بالوكالة، ويحوّل المقاومة إلى أزمة داخلية تُدار بدل أن تُطلق. ولن يكون هناك مشروع سوري جامع ما لم يتم تفكيك الرؤية الطائفية التي تعمل بوصفها ماكينة إعادة إنتاج للهشاشة، ومصنعًا دائمًا للارتهان.
إعادة إنتاج الخرائط
في الخطاب الإسرائيلي تجاه سوريا، يبرز تعبير “حماية الأقليات” ليس كمجرد “شعار إنساني”، بل كأداة استراتيجية متعددة الوظائف، تُستخدم لتغليف التدخل غير المباشر بغلاف أخلاقي زائف، ولإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية تحت عباءة العناية بالضعفاء. هذه الأداة ليست وليدة اليوم، بل تجد جذورها في سردية متكررة، بدأت مبكرًا بعد نكبة فلسطين، حين دفعت إسرائيل المجتمع الدرزي في الداخل المحتل إلى الاندماج القسري ضمن جهازها الأمني والعسكري عبر قانون الخدمة الإلزامية، في محاولة لخلق نموذج أقلية “موالية” تُوظَّف داخليًا لتفتيت الهوية الفلسطينية، وتُصدَّر خارجيًا كدليل على “تعددية الدولة العبرية”. ومع ذلك، قاومت الحركة الوطنية الدرزية هذا المسار لعقود، ورفض كثير منها الانخراط في مشروع يشرعن الاحتلال ويؤبد التمييز. وعادت هذه المعادلة إلى الواجهة حين صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل “ملتزمة “أخلاقيًا” بعدم السماح بحدوث “مجزرة ضد الطائفة الدرزية في سوريا”. لكن المفارقة الأخلاقية هنا فادحة: الدولة ذاتها التي تقونن التمييز ضد مواطنيها العرب، وتقصف المدنيين في غزة، وتُحاصر الفلسطينيين في الضفة، وتعتدي على لبنان وسوريا، تتحدث فجأة بلسان الراعي الإنساني! ما تسعى إسرائيل إليه ليس إنقاذ “طائفة محاصرة”، بل بناء نقطة ارتكاز داخل الخارطة السورية يمكن إعادة تفعيلها لاحقًا كوسيلة ضغط، أو كحزام أمني ناعم لا يتطلب وجوداً عسكرياً مباشراً. إنها سياسة استباقية تهدف إلى حياكة شبكة علاقات داخل سوريا تُمكّن إسرائيل من التحرك بمرونة حين تنضج الظروف. وكما قال تشرشل: ” في السياسة لا توجد صداقات دائمة، بل مصالح دائمة”، يبدو أن تل أبيب تسعى إلى صياغة مصالحها عبر تفكيك البنى الوطنية، لا مواجهتها. وهنا تندرج فكرة “سوريا المفيدة”، التي روّجت لها مراكز التفكير الاستراتيجي الإسرائيلية، باعتبارها الحصيلة المنطقية لتفكك الدولة السورية: طوائف تُحكَم ذاتياً، وكيانات تُغلّف نفسها بدروع مذهبية، وخرائط جديدة تُرسم داخل الخرائط القديمة. وهذا – بطبيعة الحال- لا يُعيد فقط إنتاج نموذج “سايكس–بيكو” بحروف طائفية هذه المرة، بل يجعل إسرائيل شريكاً في صوغ الهوية السياسية للمشرق، لا مجرد متطفل عليها. إسرائيل التي طالما خافت من أن تبقى “حارة يهودية وسط الوطن العربي”، تدفع الآن بكل قواها لجعل المنطقة تشبهها: فسيفساء طائفية وهويات متناحرة، تُدار عبر خطوط تماس لا حدود دولية، وتُبنى حولها علاقات “تبعية وظيفية”، لا شراكة وطنية أوقومية.
تهشيم الجغرافيا الهشة
في هذه البيئة، تبدو الطائفية وكأنها شكل من أشكال الحكم غير المُعلَن، تقوم على مظلوميات متبادلة، ومخاوف مزمنة، وشعور دائم بأن “الآخر” تهديد وجودي. وهنا تستثمر إسرائيل ليس فقط في الانقسام، بل في الحاجة إلى “الحماية”، وتُقدِّم نفسها كـ”قوة توازن” لا كقوة احتلال. وهذا هو أخطر أشكال التدخل: حين يتحول الخصم إلى ضامن، والمحتل إلى شريك، والمشروع التفكيكي إلى سردية خلاص. ومخاطر هذا التسلل الطائفي الإسرائيلي لا تقتصر على الداخل السوري، بل تمتد كأمواج دوّامة إلى الإقليم كله. فالهويات حين تُهشَّم، لا تبقى محصورة داخل الجغرافيا التي تنفجر فيها، بل تُصدِّر ارتجاجاتها إلى المحيط، خاصة في غياب المشروع المضاد. والسؤال المركزي هنا: من يردع إسرائيل؟ ليس فقط بالمعنى العسكري، بل بالمعنى الحضاري والسياسي؟ من يمتلك القدرة على تقديم نموذج دولة يتجاوز المذهب والطائفة والعِرق؟ دولة تُعيد تأسيس المواطن بوصفه كائناً سياسياً لا طائفياً، وتحميه بالعدالة لا بالولاء، وبالمساواة لا بالخوف؟
الفراغ العربي
اليوم، تتحرك إسرائيل في فراغ عربي قاتل، يفتقر إلى المبادرة والرؤية، وتتآكل فيه البنى القومية كما تتآكل الأطراف المتروكة في العاصفة. الأمم المتحدة نفسها، التي كان يُفترض أن تشكل مظلة شرعية، أصبحت عاجزة عن وقف المجازر أو الحد من الأطماع. وفي هذا الفراغ، تُعيد تل أبيب تموضعها، فتُبرر القصف بالحماية، والاختراق بالوساطة، والهيمنة بالاستقرار. وهذا ليس محض تكتيك؛ بل عقيدة متكاملة تقوم على “الهندسة الناعمة للهويات”. الردع الحقيقي لا يكون بالصواريخ وحدها. كما أن الرد على الطائفية لا يكون بطائفية مضادة، بل بتأسيس وطن يتسع للجميع. المشروع البديل هو في استعادة سوريا ككيان سياسي جامع، يحتوي مواطنيه دون استثناء، ويمنحهم شعوراً بالانتماء لا بالخوف. وحدها الدولة التي تتجاوز تقسيمات الولاء واللون الواحد قادرة على إعادة إنتاج معنى “الهوية الجامعة”، وقادرة في الوقت ذاته على إغلاق الباب أمام الطموحات الإسرائيلية، ومنعها من أن تتحول من فرضيات عسكرية إلى هندسة واقعية مستدامة.
فإسرائيل، كما يقول أحد جنرالاتها السابقين، “لا تخشى الخصوم الذين يملكون السلاح، بل أولئك الذين يملكون رؤية”. القوة التي لا ترافقها فكرة، تشبه السيف بلا يد. أما الفكرة التي تستند إلى مشروع وطني صلب، فبوسعها أن تُربك أقوى العقائد الأمنية. وقد قرأنا في الفكر الصهيوني أنَّ ما لا يمكن تحقيقه بالقوة، يمكن تحقيقه بالمزيد من القوة. لكن ما تخشاه إسرائيل اليوم، هو أن تولد في محيطها دولة تقول العكس: “ما لا يمكن الحفاظ عليه بالقوة، لا يستحق أن يُبنى بالقوة”. وفي هذه اللحظة تحديدًا، يكون الصراع ليس على الأرض فقط، بل على المعنى. على هوية المكان، على سرديته، وعلى من يملك الحق في تسميته وطنًا.
وطنٌ تديره دولة سورية جديدة قادرة على تجاوز الانقسام، وتبني مفهوم المواطنة على أساس العدالة لا الحماية. المشروع المضاد للخطوات الإسرائيلية العملية، يبدأ من الداخل. من إعادة تعريف سوريا كدولة لكل مواطنيها، دولة تقطع الطريق على كل مشروع تفتيتي، وتعيد للهوية معناها، وللسيادة كرامتها. وحدها هذه الدولة، بكل ما تتطلبه من شجاعة سياسية وخيال وطني، يمكن أن تُفشل الرهان الإسرائيلي وتُخرج تل أبيب من دور “المنقذ الإقليمي”. وإن لم يُكسر هذا المسار الآن، فإن الخارطة المقبلة للمنطقة برمتها تُرسَمُ في مراكز التفكير الأمني الإسرائيلي، ولن توقفها بيانات الإدانة والشجب والتنديد.
تلفزيون سوريا
—————————–
الدروز في زمن اليقظة/ مكرم رباح
على “الجهّال” أن يقرأوا التحولات بعمق، لا أن يتنافسوا على فرض هوية سياسية مدمِّرة للطائفة
آخر تحديث 20 مايو 2025
“قومٌ بلا جُهّال ضاعت حقوقهم، وقومٌ بلا عُقّال صاروا قَطايع”.
لعل هذه الحكمة تعبّر في جوهرها عن الوضع الراهن في سوريا، إذ تتصاعد المواجهة بين الإدارة الجديدة للرئيس أحمد الشرع، ودروز سوريا الذين ما زالوا يرفضون مركزية السلطة وفرض نزع سلاحهم بالقوة، ودمجهم قسرا ضمن الجيش السوري الجديد.
الجدلية بين “العُقّال” و”الجُهَّال” في السياق الدرزي تتجاوز التقسيم الديني الداخلي، ذلك أن رجال الدين (المشايخ) يُعَدون طبقة “العُقَّال”، أما العامة من غير المتدينين فيُطلق عليهم “الجهّال”، الذين لا يُسمح لهم بالخوض في أسرار العقيدة. لكن في الحالة الراهنة، بات المصطلح يُستخدم بشكلٍ مجازي للدلالة على الانقسام السياسي داخل الطائفة، بين دعاة الحكمة والحفاظ على الوجود، ودعاة المغامرة والانخراط في مشاريع أكبر من طاقتهم.
في هذا السياق، تصبح “اليقظة” ضرورة استراتيجية، لا تعني الاستسلام أو التواري خلف الشعارات الكبرى، بل تعني الاعتراف بحجم الذات السياسي والديموغرافي، مقابل اتخاذ مواقف صلبة– وربما عنيفة إذا لزم الأمر– لضمان الحقوق والكرامات. اليقظة هنا ليست دعوة للعزلة أو الانفصال، بل لفهم موقع الدروز– والسوريين عموما– في خريطة الصراع الإقليمي، والتعامل معهم على أنهم شركاء حقيقيون، لا رعايا تابعون ولا مشاريع مؤقتة.
فاليقظة لا تعني التخندق بل الوعي، ولا تعني الاستسلام بل الكرامة. إنها فنّ الإمساك باللحظة التاريخية وتحديد حجم الدور الممكن تأديته دون التوهم بأن الطائفة قادرة وحدها على تغيير مسارات دولية. كما أنها ترفض خطابا قديما يعيد إنتاج الانقسام بين الانعزالية والمغامرة، وتقدّم بدلا عنه مزيجا من الواقعية السياسية والتجذر المجتمعي.
في سوريا، يشكّل “العُقال”– بالمعنى السياسي– الغالبية داخل الطائفة الدرزية، ويتركز همّهم على البقاء على أرضهم، والتمسّك بكرامتهم، ورفض الانخراط في مشاريع سياسية وحدودية أو تقسيمية قد تجرّهم إلى الهلاك. في المقابل، تبرز فئة من “الجهّال” بالمعنى السياسي، تدعو للانخراط في صراعات إقليمية كسبيل للتموضع، فتارة يؤكدون على “عروبة وإسلامية” الطائفة، وتارة يروّجون للارتهان لمحاور دولية وإقليمية، لا سيما إسرائيل، مستندين إلى روابط الدين والقربى مع دروز إسرائيل.
إن الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا في جرمانا وأشرفية صحنايا، بين مجموعات درزية وقوات تابعة للحكومة الانتقالية وحلفائها من الفصائل الإسلامية، ليست مجرد حدث عارض، بل تعبير جوهري عن فشل الحكم الجديد في تقديم نفسه كممثل لكل السوريين. كما أنها دليل إضافي على إخفاق الحكم في طمأنة الأقليات بأن مصيرها في عهده سيكون مختلفا عن مصير العلويين في الساحل، الذين استُبعدوا من صُنع القرار رغم أنهم لم يكونوا جزءا من الانقلاب.
تكمن خطورة هذا الصراع في كونه يختبر حدود صبر الأقليات، ويطرح تساؤلات وجودية حول معنى الانتماء إلى دولة لا تعترف بخصوصياتهم، بل تطالبهم بالذوبان الكامل في مشاريع عسكرية لم يُستشاروا في صياغتها.
أعاد ردّ النظام بعنف على احتجاجات الدروز، إلى الواجهة حقيقة أن بناء دولة لا يُحققه مرسوم رئاسي أو رفع شعارات تنادي بالوحدة، بل إنه نتاج عقد اجتماعي جديد يحمي التنوّع ويمنح الأقليات ضمانات دستورية. هذا ما فشل النظام الجديد في تقديمه حتى الآن، مما يهدد بتوسيع الشرخ بينه وبين المكونات غير السنّية.
من الضروري في هذا السياق التمييز بين دروز سوريا ودروز لبنان وإسرائيل، على صعيد التركيبة الاجتماعية والسياسية. فجبل الدروز (أو جبل العرب كما يُفضِّل البعض تسميته) كان دائما كيانا مختلطا، لكن النظام البعثي قمع الزعامة الدرزية السياسية لعقود. فسلطان باشا الأطرش، رغم حيثيته كرمز وطني، قضى أيامه الأخيرة في نوع من الإقامة الجبرية في القريا. أما القادة التاريخيون الآخرون مثل شبلي العيسمي (الذي خطفه النظام السوري عام 2011 من لبنان) وسليم حاطوم وفهد الشاعر، فهُم نماذج حول مصير الدروز الذين تحدّوا النظام.
في ظل غياب التمثيل السياسي، تولّت المَشيخة الروحية في السويداء زمام القيادة الرمزية للطائفة، ممثّلة بمشايخ العقل الثلاثة (آل جربوع، آل حناوي، آل الهجري) الذين، رغم تقديرهم، لم يتحوّلوا إلى زعماء سياسيين، ولا يبدو أنهم يطمحون لذلك.
في المقابل، دروز لبنان يدورون بمعظمهم في الفلك السياسي لوليد جنبلاط، الذي تجاوز في العقود الأخيرة الانقسام التقليدي بين آل جنبلاط وآل أرسلان، وأصبح الممثل السياسي الأول للدروز. أما في فلسطين المحتلة، فإن المرجع الروحي هو الشيخ موفق طريف، سليل عائلة دينية بارزة، لكنه لا يدّعي تمثيل الموقف السياسي للدروز في إسرائيل، كما أن علاقته بالدولة العبرية تبقى دينية أكثر منها سياسية.
العلاقة بين دروز الدول الثلاث تتجاوز الحدود والجغرافيا، فالتعليم الديني الدرزي يرسّخ مبدأ “الذود عن الإخوان”، الذي يجعل كل درزي مسؤولا عن الآخر. لكن هذا الرابط لا يعني تبني المواقف السياسية ذاتها. فمشاركة 500 درزي من الجولان في زيارة مقام النبي شعيب مؤخرا لا تعني تطبيعا مع إسرائيل، ويجب عدم تحميلها أكثر من بعدها الروحي والاجتماعي.
من هنا، من الخطأ الرهان على أن حكومة نتنياهو ستتدخل عسكريا لحماية دروز سوريا، إذ إن سجل هذه الحكومة، التي تفاوضت مع “حماس” على حساب رهائنها، يُظهر أنها لا تعبأ كثيرا بالدم اليهودي، فكيف بالدرزي؟ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر للدروز كشركاء مخلصين في جيشها، وتحترمهم لدورهم التاريخي، وقد تقدّم بعض الدعم المحدود كما فعلت في لبنان إبان حرب الجبل، لكنها لن تتحوّل أبدا إلى ذراع تنفيذية بيد مشايخ السويداء.
وحتى هذا الدعم– إن حصل– يبقى محكوما بسقف سياسي تحدده تل أبيب وفق مصالحها، وليس وفق حاجات المجتمع الدرزي أو رغباته. اليقظة الحقيقية هنا تعني التحرر من أوهام الحماية الخارجية، والإدراك بأن مناعة المجتمع تبدأ من داخله لا من حلفائه.
وعند الحديث عن واقع السويداء، تجدر الإشارة إلى أن المحافظة ذات غالبية درزية مطلقة، ومن هنا، فإن إصرار حكومة الشرع على إدخال قوات نظامية، معظمها من رفاق سلاحه السابقين في تنظيماته الجهادية، يشكّل استفزازا خطيرا. والأجدى التوصل إلى تفاهم على صيغة محلية أمنية، تحفظ كرامة أهالي المنطقة، بدلا من فرض السيطرة بالقوة.
على “الجهّال”، من الدروز وغيرهم، أن يقرأوا التحولات بعمق، لا أن يتنافسوا على فرض هوية سياسية مدمِّرة للطائفة. وفي المقابل، على الدروز الذين يطالبون بالحماية الدولية أن يَتَيّقظوا لكون انخراطهم في مواجهة قوات الشرع تزامن مع إعلان تركيا السماح لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها نحو أذربيجان، وهي خطوة صغيرة في الشكل، لكنها عميقة في المضمون. إذ تشير إلى أن التفاهمات الإقليمية تجري فوق رؤوس “القبائل الصغيرة”، وأن التضحيات لا تساوي شيئا أمام مصالح الكبار.
وما لم يدرك الدروز هذا الواقع، فإنهم مهددون بالتحول إلى ورقة تفاوضية في صراعات الآخرين. أما الخيار البديل، فيكمن في بناء سردية سياسية مستقلة تعيد تأطير العلاقة مع المركز، وتؤسس لحوار داخلي يحدد بوضوح ماهية الدور الذي يمكن أن تؤديه الطائفة داخل سوريا الجديدة، دون تهويل أو تبعية.
وختاما، فإن دروز سوريا، شأنهم شأن باقي السوريين، خائفون من مستقبل غامض. تجاربهم مع نظام “البعث”، ومع إدارة الشرع الحالية، لا تبشّر بخير. نزع سلاحهم الثقيل والمتوسط قد يكون خطوة ضرورية، لكن لا يمكن أن يتم دون ضمانات حقيقية بوجود دولة، وليس بوجود جهاز أمني جديد يحمل اسم “الجيش السوري”.
لا يكمن التهديد الحقيقي في وجود الدروز وسلاحهم، بل في استمرار الإنكار الرسمي لحقيقة أن بناء سوريا الجديدة يتطلب شراكة وطنية ودستورية، تضمن للأقليات، ومنهم السنّة، الشعور بأنهم شركاء حقيقيون في بيت سوري متداعٍ، لكنه بيتهم رغم كل شيء.
إن استمرار إنكار السوريين لواقع الطائفية في البلاد لا يختلف كثيرا عن نهج “البعث” في طمس الهويات وقمع التعبير عنها. والاعتراف بهذا المرض السياسي والاجتماعي هو بداية العلاج، لا نقيضه. فجزء من الحل يكمن في بناء مؤسسات دستورية قادرة على تحويل تلك الانقسامات الطائفية من مصدر تهديد إلى إطار قانوني يضمن المساواة، ويحوّل الطائفة إلى مكوّن وطني لا إلى مشكلة أمنية. هكذا فقط يمكن للسوريين أن يشرعوا فعليا في بناء وطن يليق بتضحياتهم ويصون كراماتهم.
المجلة
———————–
========================
لقاء الشرع-ترامب ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تحديث 23 أيار 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
——————————-
ثلاث أولويات أمام المصرف المركزي السوري مع رفع العقوبات/ عبد القادر حصرية
سوريا بعد العاصفة… هل تكون السياسة النقدية بوابة التعافي؟
23 مايو 2025
بعد أكثر من عقد ونيف من الحرب، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة. فمنذ اندلاع الصراع عام 2011، دُمّر أكثر من نصف البنية التحتية في البلاد، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 60 في المئة، فيما يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر. وفي حين كان التركيز العالمي منصبا على المأساة الإنسانية والسياسية، فإن البعد الاقتصادي، على أهميته، ظل مهمشا في السرد الدولي.
لكن التحولات السياسية الأخيرة، وأبرزها سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي وإعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع العقوبات عن سوريا، وإعلان الإتحاد الأوروبي النية لرفع العقوبات عن سوريا أيضا، فتح نافذة نادرة. إنها لحظة إعادة نظر، وفرصة لبناء اقتصاد جديد من تحت الأنقاض، أكثر مرونة وانفتاحا واستقلالية. إلا أن هذا المسار لن يكون ممكنا من دون إصلاح جذري يبدأ من قلب النظام المالي: مصرف سوريا المركزي.
بين السياسة والنقد
تُعد تجربة مصرف سوريا المركزي واحدة من أكثر التجارب تعقيدا في إدارة السياسة النقدية تحت الضغط السياسي الدولي. فالعقوبات الغربية، على الرغم أنها وُضعت في الأصل بهدف الضغط على النظام السياسي، أثرت إلى حد بعيد في قدرة المصرف على أداء أبسط وظائفه: إدارة العملة، الحفاظ على الاستقرار النقدي، تمويل الواردات الحيوية، وحتى الإشراف على النظام المالي. والأسوأ، أن هذه القيود لم تسقط بسقوط النظام، بل لا تزال قائمة، وتعرقل أي جهد جاد لبناء مؤسسات اقتصادية فعالة.
وهذا ما يجعل رفع العقوبات الأميركية وكذلك قرار الإتحاد الأوربي قرارات بالغة الأهمية. فهي لا تمثّل فقط تحولا في السياسة، بل فرصة عملية لتجديد الانخراط الدولي، واستعادة الثقة، وإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي.
ثلاث أولويات
لا بد، كي تستطيع سوريا المضي قدما في سلوك مسار التعافي، أن يتحول المصرف المركزي من أداة دفاعية إلى محفز استراتيجي للنمو والاستقرار. ويتطلب تحقيق هذا العمل على ثلاث جبهات:
أولا: تحديث السياسة النقدية
الانتقال من التدخلات القصيرة الأمد إلى سياسة قائمة على قواعد واضحة أمر حتمي. في الأفق، نعمل على تبني نظام “استهداف التضخم”، مدعوما باستقلالية مؤسساتية للمصرف المركزي وفق المعايير الدولية، وشفافية في إدارة السيولة، وتحسين جودة البيانات. كذلك، فإن استقرار سعر الصرف أصبح الآن ضرورة. فتقلب سعر الصرف لا يخلق فقط تشوهات اقتصادية، بل يقوّض ثقة المستثمرين، ويضعف فعالية السياسات.
ثانيا: إعادة بناء النظام المالي
المصارف السورية تحتاج إلى التحول من مؤسسات حفظ ودائع إلى محركات للإقراض والاستثمار. يتطلب ذلك إعادة هيكلة شاملة: تعزيز معايير كفاية رأس المال، تحسين الحوكمة، وتوجيه التمويل نحو مشاريع إنتاجية – خصوصا في البنية التحتية والقطاع الخاص. وقد أبدت مصارف إقليمية، من المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، اهتماما مبدئيا بالاستثمار حالما يتم رفع العقوبات فعليا، مما يشير إلى وجود شهية حقيقية للانخراط المالي.
ثالثا: الانفتاح على النظام المالي العالمي
لن تكون مواردنا المحلية كافية لإعادة الإعمار. نحن في حاجة إلى تدفقات رأسمالية خارجية، من القطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من بناء بيئة استثمارية شفافة، تعزز حماية المستثمر، وتكافح غسل الأموال بصرامة. السوريون في المهجر، بكفاءاتهم ورؤوس أموالهم، يمثلون شريكا محوريا في هذه العملية، ونحن نعمل على أدوات مالية تتيح لهم المشاركة دون أن يخضعوا للأخطار السياسية المعتادة.
وفي ضوء التحولات الراهنة، يتمثل أحد المحاور الجوهرية لعمل مصرف سوريا المركزي في إعادة مواءمة السياسات والإجراءات مع المعايير العالمية المعتمدة في العمل المصرفي. تتبلور الرؤية في بناء مؤسسة نقدية مستقلة وفعالة، تتبنى أطر الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطبق معايير “بازل” لإدارة الأخطار وكفاية رأس المال، كما تعتمد الأنظمة المحاسبية والرقابية المعترف بها دوليا.
الهدف ليس فقط تحسين الأداء المحلي، بل أيضا تمكين النظام المصرفي السوري من الاندماج التدريجي والآمن ضمن النظام المالي العالمي، عبر استئناف العلاقات مع المصارف الدولية، والانخراط في شبكات الدفع العالمية، واستقطاب استثمارات مباشرة وغير مباشرة. ويُعد هذا الاندماج شرطا أساسيا لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع قاعدة التمويل، ودعم جهود إعادة الإعمار الشاملة التي تحتاجها البلاد بشدة.
نتطلع الى شراكات قائمة على المصالح المتبادلة
نحن لا نطلب تبرعات ولا مساعدات مشروطة، بل شراكات قائمة على المصالح المتبادلة. فاستقرار سوريا ليس مسألة محلية فقط، بل مصلحة إقليمية ودولية. عزل مصرف سوريا المركزي لا يضر فقط باقتصادنا، بل يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في النظام المالي الإقليمي ككل.
وفي هذا السياق، نرحب بأي تعاون مع المؤسسات المالية الدولية -كصندوق النقد والبنك الدولي- ليس فقط للحصول على تمويل، بل لبناء القدرات، وتبني أفضل الممارسات، وتصميم سياسات واقعية تراعي ظروفنا المعقدة.
المصرف المركزي يحمل عبء توجيه البوصلة
في النهاية، لا يكفي انتهاء الحرب لتبدأ عملية التعافي. بل نحتاج إلى مؤسسات ذات صدقية، وشفافية، وقدرة على التخطيط للمستقبل. ومن بين هذه المؤسسات، يحمل مصرف سوريا المركزي عبئا ومسؤولية مزدوجة: كبح جماح التدهور، وتوجيه البوصلة نحو اقتصاد مستقر ومنفتح.
رفع العقوبات هو بداية. لكن النجاح سيتوقف على ما إذا كنا، كسوريين وشركاء دوليين، مستعدين لتحويل هذه الفرصة إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو التعافي.
المجلة
———————————–
رفع العقوبات.. قرار تاريخي يغيّر الاتجاهات في سوريا/ جنى العيسى | خالد جرعتلي | حسن إبراهيم | أمير حقوق
شكّل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حدثًا تاريخيًا، ستنتهي بموجبه، بشكل مباشر أو تدريجي، تلك العقوبات التي بدأت واشنطن بفرضها على دمشق عبر قرارات متعددة منذ 46 عامًا في عهد الأسد الأب.
رفع العقوبات، الذي سعت إليه الإدارة الجديدة لسوريا دبلوماسيًا بكثافة منذ تسلّمها زمام الحكم في سوريا عقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024، من شأنه أن ينقل البلاد إلى مستويات أفضل بكثير مما تعانيه حاليًا، ليس على صعيد الاقتصاد والمعيشة والإنتاج فقط، إنما قد يبرز الانعكاس السياسي على علاقاتها بالكثير من الدول، ويفتح لها المجال أمام شراكات تغيّر مصيرها.
نتيجة استخدام النظام المخلوع آلته العسكرية ضد الشعب الذي خرج مطالبًا بالحرية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسات حكومية، ومنعت التعامل معها، وقد دفع الشعب السوري ثمنًا باهظًا جراء ذلك، إذ تأثّر أضعاف تأثّر النظام وواجهاته وقياداته، وكانت آخر الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66%.
رفع العقوبات في هذا التوقيت من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، كما أنه بوابة ستدفع البلاد إلى التغيير الإيجابي، سواء في المستقبل القريب أو على المدى البعيد.
تحاول عنب بلدي في هذا الملف تسليط الضوء على أثر رفع العقوبات عن سوريا، وتحليل الحالة القانونية للعقوبات المفروضة منذ عقود، مع الإشارة إلى الظرف السياسي الجديد الذي قد تعيشه سوريا مستقبلًا في إطار الشروط الأمريكية التي فُرضت مقابل رفع العقوبات.
منظومة معقدة.. الرفع يحتاج أشهرًا
لطالما كانت العقوبات الأمريكية على سوريا من أكثر أدوات الضغط تعقيدًا وتشابكًا واستمرارية في السياسة الخارجية الأمريكية، وتعاظمت عبر السنوات لتصبح آليات هدفها العزل التام للنظام السوري سياسيًا واقتصاديًا، حيث بدأت أولى هذه العقوبات عام 1979 عندما أُدرجت سوريا على قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.
زادت العقوبات الأمريكية خلال السنوات، وتنوّعت بين فردية تطال أشخاصًا محددين، وقطاعية تستهدف مجالات مثل النفط والطاقة والبناء، وعقوبات فُرضت عبر قرارات تنفيذية رئاسية وأخرى تشريعية، أبرزها “قانون قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، ووسّع نطاق الاستهداف ليشمل داعمي النظام من أطراف خارجية.
ويتّسم ملف العقوبات بتعقيد كبير نتيجة تداخله مع قضايا دولية، منها مكافحة الإرهاب، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية، والأمن الإقليمي. ولم تقتصر تأثيراتها على النظام فقط، بل امتدّت لتطال الحياة الاقتصادية والإنسانية اليومية للسوريين.
الإدارة الأمريكية في حيرة
إعلان ترامب رفع العقوبات على سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين وبعض أفراد إدارته، ووضعهم في حيرة، إذ رأى كبار المسؤولين في الوزارتين أن رفعها سيكون معقّدًا وسيستغرق أشهرًا، وفق ما نقلته “رويترز”.
رفع العقوبات نادرًا ما يكون مباشرًا، وغالبًا ما يتطلّب التنسيق الوثيق بين العديد من الوكالات الأمريكية المختلفة والكونغرس. ويشكّل الأمر تحدّيًا خاصًا في حالة سوريا، نظرًا لمستويات التدابير المتعدّدة التي تعزلها عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.
إدوارد فيشمان، المسؤول الأمريكي السابق ومؤلف كتاب “نقاط الاختناق”، قال لـ”رويترز” إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي فُرضت بموجب مزيج من الأوامر التنفيذية والقوانين، قد يستغرق شهورًا. ومع ذلك، أشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية لديها خبرة سابقة في تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي عام 2015.
ما يزيد المهمة تعقيدًا هو العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، إذ يتطلّب إلغاء مشروع القانون إجراءً من الكونغرس، لكنه يتضمّن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها، وفق “رويترز”.
وقال فيشمان إنه سيتفاجأ إذا تم رفع كل العقوبات كجزء من أمر ترامب، مضيفًا أن بعض الأشخاص أو الكيانات المحددة في سوريا التي فُرضت عليها عقوبات لأسباب تتعلّق بسلوك محدد، مثل دعم جماعة إرهابية، قد لا يتم إزالتها من قائمة العقوبات.
عقوبات رئاسية وتشريعية واستنادًا لحالات طوارئ
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال لعنب بلدي، عبر مراسلة إلكترونية، إن الولايات المتحدة لا تزال تراقب استجابة دمشق للتدابير المحددة والمفصلة التي طرحتها واشنطن سابقًا، مضيفًا أن تخفيف العقوبات يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا ودفعها نحو السلام.
وذكر أن الولايات المتحدة اتخذت بالفعل الخطوات الأولى نحو استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، من خلال اجتماعها مع “السلطات المؤقتة”.
وأضاف أنه لا توجد معلومات لمعاينتها حاليًا في هذه المرحلة فيما يتعلق بالجدول الزمني لبدء رفع العقوبات.
وقال المسؤول، “لقد طلبنا من السلطات السورية المؤقتة اتخاذ تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة. ونواصل تقييم استجابتها”.
الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي ذكر أن العقوبات الأمريكية على سوريا متنوعة، منها رئاسية (تصدر بقرار من الرئيس الأمريكي)، عددها ثمانية أوامر تنفيذية رئيسية أصدرها رؤساء الولايات المتحدة لفرض عقوبات على سوريا، بدءًا من عام 2004 وحتى عام 2019.
وتشمل العقوبات الرئاسية معظم العقوبات على الاقتصاد السوري، وتُفرض عبر “أوامر تنفيذية”، ويمكن للرئيس ترامب أن يلغي أو يجمّد هذه العقوبات فورًا، دون الحاجة للرجوع إلى الكونغرس، وفق ما نشره بربندي.
وأضاف أن هناك عقوبات تشريعية وهي قوانين أصدرها الكونغرس مثل “قانون قيصر”، وهي أكثر تعقيدًا، لأنه لا يمكن للرئيس وحده إلغاؤها، ويتطلّب رفعها أن تثبت الإدارة الأمريكية للكونغرس أن سوريا حققت الشروط الموجودة في القانون نفسه.
ولفت بربندي إلى أن العديد من العقوبات تستند إلى “حالة طوارئ وطنية” يتم تجديدها سنويًا، وإذا لم يُجدّدها الرئيس، تُعلّق بعض العقوبات بعد ستة أشهر، وهنا يمكن تخفيف العبء الاقتصادي جزئيًا، حتى لو لم يتم إلغاء القانون نفسه.
وبحسب بربندي، يمكن لترامب أن يُلغي الأوامر التنفيذية التي فرضت عقوبات اقتصادية، ويصدر تراخيص استثنائية لتسهيل التحويلات أو الاستيراد، ويُعدّل بعض الفقرات حتى لا يشمل رفع العقوبات الأشخاص والشركات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويُعلّق تطبيق العقوبات في حال لم يُجدّد حالة الطوارئ.
ولن يستطيع الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المرتبطة بـ”قانون قيصر” إلا إذا تحقّقت الشروط التي يطلبها الكونغرس، لكنه يستطيع إلغاء بعض المواد فيه، وفق بربندي.
“رفع تدريجي” مرهون بالتجاوب السوري
المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، قال لعنب بلدي إن ملف العقوبات معقد، ورفعها يستغرق وقتًا، لافتًا إلى أن الرفع سيكون بشكل تدريجي ومجدول وتعاظمي. الأدوات بيد الرئيس ترامب والحكومة الأمريكية اليوم هي “الترخيص”، وهو أسلوب لتعطيل العقوبات عبر السماح لشركات بالعمل في قطاعات سورية خاضعة للعقوبات.
وأضاف الغبرا أن جزءًا كبيرًا من هذه العقوبات مشمول بقوانين، بعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهناك ضرورة للعمل نحو إصدار قوانين جديدة، وهذا يستغرق وقتًا ومباحثات في أروقة الإدارة الأمريكية، وما سيفعله ترامب هو العمل على تعطيل العقوبات حتى يتم رفعها بشكل قانوني ورسمي مستقبلًا.
وتابع الغبرا أن الأمر مرهون بالتجاوب وقدرة الحكومة السورية على الالتزام بالخطوط العريضة، على الأقل، التي اتفق عليها الطرفان في المرحلة القادمة، وعبر العمل مع السعودية وتركيا، وهما بمثابة الدول المساعدة التي ستحاول العمل مع الحكومة السورية لمساعدتها على الوصول إلى مرحلة متقدمة، بعيدًا عن العودة إلى العقوبات.
ولفت الغبرا إلى أن التفكير اليوم في واشنطن هو أن يكون هناك ترخيص لمدة عامين، مع مراجعته كل ستة أشهر، ويتم تعديله حسب الحاجة، بينما يتم العمل مع الكونغرس الأمريكي لرفع العقوبات بشكل رسمي عبر قانون.
تقارب مشروط.. المكاسب في أي سلّة
يتفق على أن إعلان ترامب حول رفع العقوبات جاء مشروطًا، وكانت واشنطن واضحة في هذا السياق، إذ طالبت الأخيرة دمشق بعدة قضايا سياسية، إلا أن التساؤلات تدور في فلك قدرة سوريا على التفاوض في ظل هذه الشروط.
جاءت تغريدة مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، موضحةً لما عقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري في المرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، إذ أوضحت كواليسه، وشددت على شروط طرحتها الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع دمشق.
وقالت ليفيت، التي كانت ترافق ترامب في السعودية، عبر “إكس”، وعقب الاجتماع مباشرة، إن الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على خمس قضايا رئيسة هي:
● التوقيع على اتفاقيات “أبراهام” مع إسرائيل.
● الطلب من جميع “الإرهابيين” الأجانب مغادرة سوريا.
● ترحيل “الإرهابيين” الفلسطينيين.
● مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
● تحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم “الدولة” في شمال شرقي سوريا.
ولم يخرج ما نقلته ليفيت عن ترامب عن إطار الشروط التي خرجت من الولايات المتحدة باتجاه سوريا منذ سقوط الأسد، لكن اللقاء بين الرئيسين عكس إصرار واشنطن عليها وقبول دمشق لها.
سوريا “بموقع قوة”
منذ سقوط النظام، كان رفع العقوبات المطلب الأول والأساسي للدبلوماسية السورية، وشهدت سوريا احتفالات واسعة النطاق بعد إعلان ترامب برفعها، ومنح سوريا “فرصة جديدة”.
المقابل الذي طرحته واشنطن اعتبره الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل أريزانتي، أنها وضعت سوريا في موقع قوي للتقدم، لافتًا إلى أن الأطراف المحيطة بسوريا صارت اليوم هي من يحتاج إلى إثبات استعدادها للسلام، وخفض التصعيد، وإعادة الاندماج الإقليمي، في إشارة إلى إسرائيل.
وأضاف أريزانتي لعنب بلدي أن إدارة الشرع أظهرت اهتمامًا واضحًا بالتطبيع، بل وحتى الانضمام إلى اتفاقيات “أبراهام”، واصفًا ذلك بـ”التحول الكبير والشجاع” بالنظر إلى التاريخ.
ولفت إلى أن المشكلة ليست في دمشق، بل في المناخ السياسي في إسرائيل، معتبرًا أن دوافع قيادة نتنياهو مبنية على تطلبات الأمن والبقاء السياسي الداخلي، وليس باهتمام حقيقي بسلام طويل الأمد.
الخبير اعتبر أنه من المرجح أن تطلب إسرائيل “شروطًا مسبقة متطرفة”، مثل التماهي الكامل مع سياساتها تجاه إيران والسيطرة الدائمة على مرتفعات الجولان.
ورجّح أن تنظر سوريا لهذه المطالب على أنها تتجاهل السيادة السورية وتجعل من التطبيع الحقيقي أمرًا أكثر صعوبة، في وقت تمد سوريا فيه يدها.
طرد الأجانب
شكل طرد المقاتلين الأجانب من سوريا ثاني الشروط الأمريكية، وشمل الجهاديين ممن قاتلوا في فصائل المعارضة، وفصائل فلسطينية كان يدعمها النظام المخلوع على مدار خمسة عقود.
الخبير أريزانتي اعتبر أن هذه الخطوة تصب في مصلحة سوريا، مشيرًا إلى أن لدى الحكومة الجديدة كل الحوافز لـ”تنظيف البيت”، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الجهادية المعترف بها دوليًا مثل تنظيم “الدولة” وتنظيم “القاعدة”.
ولفت إلى أن خطوة من هذا النوع تعزز الشرعية، وتقرب البلاد من تخفيف العقوبات، وتزيد من الثقة الإقليمية، لكن التحدي يكمن في القيام بذلك دون زعزعة الاستقرار المحلي.
وبالنظر إلى المشهد العام، اعتبر الخبير أن لا أحد لديه ما يكسبه من إزالة هذه العناصر أكثر من سوريا نفسها، وهو أبرز المكاسب الاستراتيجية لدمشق إن تحقق.
القيادة الجديدة تسعى إلى النأي بنفسها عن ذلك الإرث، وترحيل المسلحين الذين يخضعون لطهران أو يسعون لزعزعة استقرار سوريا يعزز موقف دمشق.
إنها خطوة ذكية ومنخفضة التكلفة تُضعف النفوذ الإيراني وتطمئن الجيران المتشككين، وعلى عكس المطالب الأخرى، فإن هذه الخطوة تتماشى تمامًا مع أهداف سوريا الأمنية والدبلوماسية، كما أنها قيد التنفيذ بالفعل، وهي من أسهل المكاسب في هذا الإطار كله، بحسب ما يرى أريزانتي.
منع عودة تنظيم “الدولة”
تزامنًا مع التطورات السياسية القادمة من سوريا، يلوّح تنظيم “الدولة الإسلامية” بخلايا الاغتيال والاستهداف والعبوات الناسفة من الشرق السوري، ويكثّف عملياتها رغم أنشطة التحالف الدولي وضده في المنطقة، وسط تحذيرات رسمية وأممية من عودة تنامي نشاط التنظيم الذي يحاول استعادة قوته على الدوام.
الخبير أريزانتي اعتبر أن تنظيم “الدولة” يجعل الأمور “أكثر تعقيدًا”، مضيفًا أنه يجب على صانعي السياسات في الغرب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم فيما يتعلق بهذه الخطوة.
وقال لعنب بلدي، إن سوريا تتعاون بالفعل مع الأردن وتركيا لتأمين حدودها ومواجهة تهديدات التنظيم.
لكن مشكلة “الفيل في الغرفة” (عالقة) هي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا، والتي تحاول الحكومة السورية دمجها بقواتها لإنهاء حالة تفردها بالسيطرة على المنطقة، معتبرًا أنها صارت كيانًا “شبه مستقل” ومدعومًا من الخارج، ويتحكم بجزء من الأراضي السورية.
أصبحت قوات سوريا الديمقراطية كيانًا شبه مستقل مدعومًا من الخارج يعمل داخل الأراضي السورية، ولا يمكنها البقاء كسلطة موازية، وإذا كان من المتوقع أن تقود سوريا حملة وطنية ضد داعش، على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتوقفوا عن التظاهر بأن نموذج قسد مستدام.
مايكل أريزانتي،
خبير في شؤون الشرق الأوسط.
واعتبر الخبير أن الحل الحقيقي يكمن في دمج “قسد” بالجيش السوري، بشروط متفق عليها، أو انتهاء استقلالها الإداري، لأن السماح لها بالعمل خارج سلطة دمشق سيؤدي إلى “تمزيق سوريا وإطالة أمد الأزمة”، وهو ما ينطبق على البند المتعلق بإدارة سجون تنظيم “الدولة الإسلامية”.
خطوات تخفي شروطًا
رسم اللقاء التاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ودونالد ترامب معالم جديدة للعلاقات السورية-الأمريكية، بشكل يتجاوز مجرد إعادة الاتصالات الدبلوماسية، لتُفتح أمامها ملفات شائكة تتعلق بخطوات ذكرتها واشنطن، وأخرى لم يعلن عنها رسميًا.
واعتبرت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، إيفا كولوريوتيس، لعنب بلدي، أن شروط واشنطن أكثر مما ذُكر عن لقاء ترامب-الشرع، إذ بدأت أمريكا مبكرًا بإرسال رسائل تعاون، وشرعت سوريا بالتنفيذ فورًا.
وقالت كولوريوتيس إن الشروط الأمريكية لا تقتصر فقط على تلك الخمس، بل تُضاف إليها ملفات أخرى تعاملت معها الإدارة السورية الجديدة وبدأت بتنفيذها، من أبرزها:
● إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا.
● محاربة شبكات إنتاج وتصدير الكبتاغون.
● منع إيصال السلاح إلى حزب الله اللبناني.
● ملف الأمريكيين المفقودين، وخاصة الصحفي أوستن تايس، حيث باشرت فرق أمريكية-قطرية عمليات البحث.
وأضافت الخبيرة أن سوريا قادرة فعلًا على تنفيذ شروط واشنطن بدعم عربي ودولي، معتبرة أنه من المهم إتمام انسحاب الولايات المتحدة من شرق الفرات لتمكين دمشق من السيطرة الكاملة على سجون تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، لفتت كولوريوتيس إلى أن “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” قد جُمّدت نشاطاتها وغادر جزء من قيادتها إلى لبنان، فيما تجري ترتيبات لنقل قيادة “حركة الجهاد الإسلامي” إلى إيران والعراق.
الاستقرار مشروط بالتشاركية
منذ سقوط النظام، تمسّكت واشنطن بثمانية شروط، جاء خمسة منها في لقاء ترامب-الشرع، لكن ثلاثة أخرى لم تذكرها مساعدة الرئيس الأمريكي، كارولين ليفيت، منها حماية حقوق الأقليات في البلاد، وتشكيل حكومة تمثيلية.
الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” معن طلاع، اعتبر من جانبه أن إدارة الملفات الداخلية هي التحدي الأكبر، رغم نجاح سوريا في إعادة تموضعها خارجيًا.
وأضاف لعنب بلدي أن سوريا وجّهت منذ اللحظة الأولى رسائل واضحة بأنها لن تكون ساحة صراعات إقليمية، بل طرفًا فاعلًا في الاستقرار المحلي، عبر العودة إلى محيطها العربي، بما يعكس هويتها الإسلامية والعربية.
وفي الوقت نفسه، حذّر طلاع من تعقيدات المشهد الداخلي، قائلاً إن “التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتطلب عقدًا اجتماعيًا جديدًا، وحوارًا وطنيًا شاملًا، وبرامج لإعادة اللاجئين، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وكلها تحتاج إلى بنية قانونية ومحلية متماسكة”.
ويرى أن “نجاح سوريا في مواجهة التحديات لا يكون من خلال الدولة فقط، بل بانخراط المجتمع في اتخاذ القرار ومراقبته وتنفيذه”، مضيفًا أن “التشاركية، لا المحاصصة، هي الضمان لبناء الدولة”.
وفيما يخص العلاقات الدولية، اعتبر طلاع أن أي انفتاح دولي يُبنى على الاستقرار سينعكس إيجابًا على سوريا، مستبعدًا أن تُنهي هذه الانفراجات التعديات الإسرائيلية على المدى القريب، لكنه يعتبرها مدخلًا لتعزيز وحدة القرار العربي، ما قد يردع بعض تلك التدخلات مستقبلًا.
وأضاف أن سوريا اليوم تقف أمام مرحلة عنوانها “تراكم الثقة”، لا الحسم، وفكرة السلام في الإقليم تتطلب مناخًا داخليًا متماسكًا، تنطلق منه القرارات الخارجية، وفق تعبيره.
الباحث معن طلاع لفت إلى أن أي انفتاح في العلاقات الدولية يقوم على مبدأ الاستقرار سينعكس بطبيعة الحال بشكل إيجابي على سوريا، مشيرًا إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى فك الحصار والعقوبات من أجل إطلاق عجلة التنمية والتعافي، كما أنها تحتاج إلى علاقات إيجابية مع دول الجوار، لأن استحقاقاتها الداخلية تتطلب تركيزًا على الداخل، لا الانخراط في محاور وصراعات إقليمية قد تُعيق هذا التركيز وتنعكس سلبيًا عليه.
أما الملفات الاستراتيجية التي يُتوقع أن تنتج عن هذه العلاقات، مثل ملف العلاقة مع الكيان الصهيوني أو انخراط سوريا في النظام الأمني الإقليمي، اعتبر طلاع أنها ستكون محل نقاش محلي، مرجحًا أن الموقف السوري سيكون منسجمًا في نهاية المطاف مع الموقف العربي العام، لكن ذلك لن ينهي الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، إذ لا يوجد اتفاق نهائي أمريكي- سوري حتى اليوم.
التعافي الاقتصادي مبشر.. ينتظر خطوات
على خلاف تعقيدات المشهد السياسي، يطل الملف الاقتصادي واضحًا عقب رفع العقوبات عن سوريا التي تعاني شحًا اليوم في مختلف الاستثمارات، ما يجعلها هدفًا جذابًا كانت العقوبات تقف بوجهه.
عودة التعامل التجاري والاقتصادي الخارجي مع المؤسسات الرسمية أو عبر الأفراد من شأنها تنشيط دورة الحياة الاقتصادية التي كانت تلفظ آخر أنفاسها منذ سنوات.
الباحث الاقتصادي ملهم الجزماتي أوضح أنه على المدى القصير لن يكون هناك تأثير كبير لرفع العقوبات، حتى تتضح الإجراءات التنفيذية للآلية القانونية لرفعها.
المستشار التنفيذي لشؤون التخطيط والمتابعة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الدكتور رازي محي الدين، قال لعنب بلدي إن الآثار الإيجابية المتوقعة لرفع العقوبات عن سوريا تبقى مرهونة بمدى تفاعل جميع مكونات المجتمع السوري من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ونخب فكرية واقتصادية، في تنفيذ برامج التعافي والتنمية، فكلما كان الأداء متناغمًا ومتكاملًا، وكلما تم تعزيز الشراكة بين هذه المكونات في صياغة وتنفيذ السياسات، كانت النتائج الإيجابية أسرع وأكثر استدامة.
وأما على صعيد التوقعات، يرى الدكتور رازي محي الدين أنه على المدى القريب (6-12 شهرًا) من المتوقع:
● تحسّن السيولة، ومع تحرير القيود المصرفية يمكّن المصارف المحلية من إجراء الحوالات واستيراد المواد الأولية والأدوية بسهولة أكبر، ما يخفف ضغوط نقص السلع الأساسية.
● انخفاض تكاليف التمويل: رفع العقوبات يقلل من غرامات ورسوم المصارف المراسلة، فينعكس ذلك على أسعار الفائدة ويحفز الإقراض للقطاع الخاص.
● إنعاش التبادل التجاري: استئناف العلاقات المصرفية الدولية يسرّع استيراد وتصدير السلع، ما ينعش بعض القطاعات الإنتاجية بسرعة.
أما على المدى المتوسط (1–5 سنوات) فمن المفترض ملاحظة تحسن كبير في عدة نقاط أبرزها:
● جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: ثقة المستثمرين سترتفع مع انفتاح البلاد مصرفيًا وتجاريًا، وستتدفق رؤوس الأموال على قطاعات البنية التحتية والصناعة والسياحة.
● تنويع الاقتصاد: حرية الوصول إلى الأسواق العالمية تشجع على تطوير قطاعات جديدة (خدمات لوجستية، تكنولوجيا معلومات، زراعة متقدمة) بدل الاعتماد على استيراد المواد الاستهلاكية.
● استدامة النمو وخلق فرص العمل: مع تحسّن المناخ الاقتصادي وتوسّع الأنشطة التجارية، سيزداد الطلب على العمالة المحلية وتقل معدلات البطالة.
رغم ما يحمله رفع العقوبات من فرص اقتصادية واعدة، إلا أن الانفتاح السريع وغير المنضبط على الأسواق العالمية قد يشكل تحديات حقيقية، خصوصًا على القطاع الصناعي المحلي، وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية، وغياب الحماية والدعم الكافي.
فمن دون سياسات حكومية رشيدة تحمي هذه الصناعات من الإغراق والمنافسة غير العادلة، قد نجد أنفسنا أمام موجة من الإغلاق وخسارة آلاف فرص العمل، مما يعاكس أهداف التنمية والتعافي.
قطاعات تتعافى
حول أبرز القطاعات التي ستتعافى عقب بدء تنفيذ عملية إزالة العقوبات عن المؤسسات، أكد ملهم الجزماتي لعنب بلدي أن جميع القطاعات ستشهد تحسنًا إيجابيًا، بالدرجة الأولى قطاعي المصارف والطاقة، إذ سيتيح رفع العقوبات للعديد من الدول الصديقة تقديم المنح النقدية للحكومة السورية، أو إيداع مبالغ مالية في مصرف سوريا المركزي.
الدكتور رازي محي الدين من جهته ذكر خمسة قطاعات ستتعافى تدريجيًا بشكل رئيسي تتمثل بما يلي:
● القطاع المصرفي والمالي: استئناف العلاقات مع المصارف المراسلة ينعش التحويلات الدولية ويخفض تكلفة الائتمان.
● الصناعات التحويلية (المواد الكيميائية والأدوية): توفير المواد الخام والتكنولوجيا الخارجية سيعجّل من قدرتها على الإنتاج والتصدير وخاصة مع تحسن وضع السلم الأهلي.
● الزراعة ومنتجات الحبوب: استيراد المدخلات الزراعية (أسمدة وآلات) يعود بالنفع الفوري على الإنتاج ويحسن الأمن الغذائي.
● الطاقة (نفط وغاز): إمكانية توقيع عقود شراكة جديدة مع شركات دولية ترفع الإنتاج وتولّد موارد حكومية إضافية.
● السياحة والسفر: رفع الحظر على التعاملات يتيح لشركات السفر الأجنبية استئناف برامجها إلى سورية، ما ينعش الفنادق والخدمات المرتبطة بها.
أموال بانتظار استردادها
حول مصير الأموال المجمدة في أرصدة البنوك الأمريكية، قال جزماتي إن هذا الملف يحتاج إلى عدة خطوات تقنية قبل الحصول عليها، أبرزها إقرار وزارة الخزانة الأمريكية، ثم إعادة ربط مصرف سوريا المركزي بنظام “سويفت”، يليه التنسيق الدولي السياسي اللازم لذلك.
يرى الدكتور رازي محيي الدين أن الأصول المجمدة تخضع لحزمة من القوانين واللوائح الأمريكية والدولية، ولا تُفرج تلقائيًا بمجرد رفع العقوبات، مشيرًا إلى عدد من الآليات المحتملة لاسترجاعها.
تتمثل تلك الآليات في اتفاقيات ثنائية وتسويات مصرفية تقنية بين الحكومة السورية والجهات المقيِّدة للأصول، أو عبر إعادة تقييم القوائم السوداء تبعًا لالتزام سوريا بشروط رفع العقوبات (مثلاً في ملف مكافحة غسل الأموال أو مكافحة الإرهاب)، بالإضافة إلى آليات قانونية دولية، عبر مؤسسات مثل محكمة العدل الدولية، أو بموجب قرارات دولية توضّح اختصاص إعادة الأرصدة إلى المصرف المركزي.
صناعيون متفائلون.. إجراءات واجبة
يُعدّ القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المتأثرة سلبًا بالعقوبات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بغياب القدرة على استيراد المواد الأولية، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وتراجع التصدير بنِسَب كبيرة، إذ انعدمت الأسواق التصريفية للمنتجات الصناعية.
ويمثّل القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد السوري، وأهم ركائزه، وبالتالي فإن رفع العقوبات سيشكّل نقطة حاسمة في إعادة عجلة الصناعة السورية، وفي مساهمتها في تعافي الاقتصاد الوطني.
رئيس لجنة العرقوب الصناعية، ونائب رئيس لجنة القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب، تيسير دركلت، قال لعنب بلدي إن قرار رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجابًا على المنحى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وخاصة الصناعة كقطاع اقتصادي، كون العقوبات كانت جائرة بحق الإنتاج الصناعي.
وتأثير رفع العقوبات على القطاع الصناعي يتمثّل بداية في مدخلات الإنتاج، إذ ستتوفّر المواد الأولية لبعض الصناعات، والتي كان يُمنع استيرادها من دول معينة، مضيفًا أن ملف تصدير المنتجات الصناعية السورية سينتعش، ويفتح أسواقًا لتصريفها، وأيضًا ستتولّد حرية نقل الأموال للصناعيين.
فرصة حيوية
عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعجي، قال لعنب بلدي إن العقوبات، على مدى عقود، كبّلت الصناعة، مما اضطر الصناعي السوري إلى إبداع طرق للاستمرار في الإنتاج والصناعة، رغم كل القوانين الجائرة التي كانت تصدر عن النظام البائد، وتزيد المعوقات، وتحاصر الصناعيين أكثر.
وأكد قلعجي أن رفع العقوبات عن سوريا سيُعيدها إلى النظامين المالي والتجاري العالميين، وهذا ما يُمكّنها من التواصل مع الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصناعة السورية، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة الصناعة من خلال استيراد المواد الأولية بيسر وسهولة من أي دولة في العالم.
واعتبر الصناعي أن رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي الصناعي السوري، وفتح مرحلة حقيقية لإعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب رفع القدرة الإنتاجية الصناعية لتغطية الطلب الكبير الذي سينتج عن هذه المرحلة.
إجراءات واجبة
يتفق الصناعيون على أنه يجب على الحكومة استغلال قرار رفع العقوبات، وتحسين قطاع الصناعة، وتذليل العقبات التي تحدّ من القدرة الإنتاجية.
تيسير دركلت أشار إلى أهمية دراسة انخفاض تكاليف الإنتاج، وتعديل بعض القوانين التي كانت تحدّ من قدرة الصناعيين، بدءًا من أسعار المحروقات، كما أن النظام الضريبي يتوجّب أن يكون عادلًا ومنصفًا للصناعيين.
بدوره، يرى الصناعي طلال قلعجي أن الصناعة السورية ستنتقل من مرحلة صعبة إلى مرحلة يستطيع فيها الصناعي تأمين مدخلات صناعته، وتطويرها تكنولوجيًا وإنتاجيًا وترويجيًا، إضافة إلى قدرة الحكومة السورية على تأمين حوامل الطاقة للصناعة.
كما سيُتيح زيادة الطلب على المنتجات زيادة الإنتاج، وبالتالي رفع القيمة المضافة للمنتج والناتج المحلي، مشيرًا إلى إمكانية عودة انتعاش صناعات مهمة وثقيلة، كإنتاج الطاقة (النفط والغاز)، والصناعات الثقيلة التي تعتمد على الطاقة، كالحديد والإسمنت وغيرها.
ووفق قلعجي، تركّز غرفة صناعة دمشق في هذا الوقت على النهوض بالصناعة السورية بكل قطاعاتها: الكيميائية، والنسيجية، والغذائية، والهندسية، وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا، من خلال دراسات يُعدّها مستشارون مختصون، عبر لقاءات شاملة مع الصناعيين، لدراسة الصعوبات والمعوقات.
تتطلع الغرفة إلى العمل على وضع استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تحليل نقاط القوة والضعف في القطاع الصناعي، إضافة إلى وضع المقترحات التي ستُقدَّم للحكومة، لتعديل القوانين الناظمة للعمل الصناعي وقطاع الأعمال، في سبيل خلق بيئة استثمارية صناعية، وتشجيع التصدير، وتخفيض كُلَف الإنتاج، حسب ما ختم به قلعجي.
عنب بلدي
—————————————–
ماذا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟/ بكر صدقي
22 أيار 2025
أخيراً حدث ما لم يكن متوقعاً وقرر ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا لـ«إعطاء القيادة الجديدة في سوريا» التي وصفها بالقوة والدينامية «فرصة». الواقع أن الإدارة الجديدة كانت في كل المناسبات الدبلوماسية التي أتيحت لها تطالب برفع تلك العقوبات باعتبارها عقبة كبيرة أمام طموحاتها بشأن إطلاق عملية إعادة الإعمار وتدوير عجلة الاقتصاد المنهار وبناء أسس «دولتها الجديدة». ولعبت كل من السعودية وتركيا دوراً مهماً في إقناع ترامب بهذه الخطوة، إضافة إلى لقائه بأحمد الشرع بناء على طلب محمد بن سلمان ومصافحته له وإملاء عدد من المطالب الأمريكية عليه.
يمكن القول إن رفع العقوبات هو حقاً فرصة لا نعرف هل ستستفيد منها إدارة الشرع وكيف، أو أنها ستهدرها كما أهدرت فرصاً أخرى قبلها، كمؤتمر الحوار الوطني واللجنة الدستورية والحكومة الانتقالية بنسختيها الأولى والثانية. والمقصود هنا استفادة لمصلحة بناء سوريا جديدة لكل أبنائها وليس لمصلحة الطبقة الحاكمة التي تشير كل مسالكها إلى أنها تسعى لتأسيس نظام أحادي يحتكر السلطة ولا يبتعد كثيراً عن نموذج نظام الأسد المخلوع إلا باللون الإيديولوجي. وقد ركزت جهودها على نيل الاعتراف والشرعية من الدول العربية والإقليمية والدولية، مكتفيةً للداخل الوطني بـ«شرعية ثورية» تعرضت لكثير من التآكل في الأشهر الستة من حكمها، ومعرضة لمزيد من التآكل باطراد. ولا يمكن لصخب الجهاز الدعائي الموالي أن يغطي على هشاشة سيطرة الحكم على فصائل محسوبة عليها تتحرك بلا أي ضوابط، ولا على الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الطاحنة التي تشمل غالبية كاسحة من السوريين، ولا على انعدام ثقة مكونات وطنية تعرضت لمجازر أو تمييز بالطاقم الحاكم.
يمكن لرفع العقوبات أن يسمح بتدفق بعض الأموال على شكل مساعدات واستثمارات وقروض ستتوقف نجاعة استخدامها على الشفافية والتخطيط السليم واعتماد معيار الكفاءة بدلاً من الولاء، وقبل كل شيء تحديد الأهداف: هل الغاية هي إعادة بناء شاملة تنتشل سوريا من هوة العدم وتبني دولة وطنية يشعر جميع السوريين أنها دولتهم، أم تثبيت أركان نظام سياسي قادر على السيطرة وإقصاء كل ما يقع خارجه؟
من المحتمل أن النواة الصلبة للحكم الجديد تفكر في حل التناقض بين متطلبات إرضاء الخارج ومتطلبات إرضاء القاعدة السلفية الجهادية التي أوصلتها إلى الحكم من خلال تقوية جهاز الأمن العام ومنح مكاسب لبعض قادة الفصائل تمهيداً للتخلص منها. وهو ما قد يؤدي إلى صدام بين الجهاز المذكور وهذه الفصائل لا يمكن التكهن بمدى دمويته. كذلك لا شيء يضمن أن يقنع قادة الفصائل بما قد يقدم لهم من مكاسب على شكل مناصب عسكرية في الجيش أو الإدارة المدنية وما يمكن أن يترتب على ذلك من مكاسب مادية. هذا المخطط المفترض أن يستعيد النمط الذي اتبعه حافظ الأسد لتوطيد أركان حكمه: توزيع المناصب والمكاسب والمغانم على رفاق الدرب الذين ساعدوه في الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها، من كبار ضباط الجيش والمخابرات إلى من بقي معه من قيادة حزب البعث، مع وضعهم تحت المراقبة وابتزازهم بملفات فسادهم المنتفخة باطراد على مر السنوات تمهيداً للتخلص منهم واحداً بعد آخر. هذا ما كانه مصير أخيه رفعت الأسد الذي قام بمحاولة انقلابية ضده، وعلي حيدر وشفيق فياض وعلي أصلان وعلي دوبا، ثم عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس وغيرهم.
غير أن الفارق بين هذا المسار وبين ما يمكن أن يرتسم من مسار أمام سلطة الشرع هو أن الأسد قد استولى على السلطة في ظروف مريحة نسبياً بالقياس إلى الوضع الكارثي لسوريا في أواخر العام 2024. كان ثمة دولة في 16تشرين الثاني 1970، وجيش وشرطة وقضاء وتعليم واقتصاد معافى بالمعايير المحلية ومجتمع غير منقسم على نفسه. واهتم الأسد الأب بنيل شرعية داخلية بقدر اهتمامه بالاعتراف الدولي، فاستمال الطبقة التجارية التي كانت متضررة من الحكم الاشتراكي المتشدد لنظام سلفه صلاح جديد، وأنشأ إطاراً تحالفياً مع مجموعة من الأحزاب القومية واليسارية في إطار أسماه «الجبهة الوطنية التقدمية»، وورث ولاء الفلاحين عن النظام السابق، كما راعى التنوع الإثني والديني والمذهبي للمجتمع فكان حريصاً على جعلهم يشعرون بأنهم ممثلون في السلطة. إن إفراغ حافظ الأسد لكل هذه الأطر من مضامينها وتحويلها، بمرور السنوات، إلى مجرد واجهات لتعزيز دكتاتورية فردية ستتحول إلى وحش دموي بدءا من العام 1980، لا يلغي واقع أنه كان حريصاً على تأمين ولاء شعبي بأوسع ما يمكن.
مؤسف أن اضطر لهذه المقارنة التي تبدو وكأنها لصالح نظام الأسد. هي كذلك من زاوية مصلحة بقاء النظام. أعني أن الأسد قد اشتغل سياسياً على تأمين قاعدة اجتماعية واسعة قدر الإمكان لتحقيق ديمومة لحكمه، في حين تعمل الإدارة القائمة اليوم في دمشق وكأنها ليست في حاجة لقاعدة اجتماعية وتحالفات سياسية مماثلة، نائمة في عسل وهم أنها تمتلك فعلاً قاعدتها الاجتماعية المتمثلة «بداهةً» في الأكثرية العددية السنّية. في حين أن السنة لا يشكلون كتلة سياسية موحدة، ناهيكم عن الكرد والشركس والبيئات العلمانية والمجموعات الإسلامية غير السلفية. هذا إذا لم نحسب الأقليات الدينية والمذهبية التي لا تثق بالإدارة القائمة.
مختصر القول إن رفع العقوبات ليس عصاً سحرية لحل مشكلات سوريا الهائلة، قد تساهم قليلاً في تخفيف حدة بعض المشكلات، لكنها لا تكفي للمضي إلى الأمام ما لم يتم ترميم الهوية الوطنية من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية والاقتصادية.
كاتب سوري
القدس العربي
———————————-
سوريا: عقد اقتصادي جديد بعد رفع العقوبات/ صبا ياسر مدور
الخميس 2025/05/22
رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا جاء كخطوة لاحقة وحتمية، بعد إعلان واشنطن فك قيودها الاقتصادية، في لحظة شكلت التحول الفعلي باتجاه إعادة دمج سوريا في السوق الدولية لعبورها إلى العالم وعبوره إليها.
ورغم أن وزن الاستثمارات الأوروبية على المدى الطويل قد يفوق ما قد تحققه المشاريع الأميركية من أثر بنيوي في الاقتصاد السوري، فإنها لم تحظَ بالاحتفاء ذاته؛ إذ جرى التعامل مع رفع العقوبات الأوروبية كتحصيل حاصل، تالية للقرار الأميركي الذي غيّر قواعد اللعبة ومنح سوريا هوية جيوسياسية غربية. هذا التحول السياسي رافقه إعلان من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه الأخير، حدد فيه ملامح التوجه الاقتصادي المقبل، موجهاً دعوة علنية وصريحة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في القطاعات المتاحة، في مؤشر واضح إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو نموذج اقتصادي حر الطابع، قائم على المبادئ النيوليبرالية والانفتاح الواسع.
وفي سياق اقتصاد الحرب الذي ما زالت ترزح تحته سوريا، حيث أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 30% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لمعيار 2.15 دولار يومياً الذي تعتمده المؤسسات الدولية، فإن الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية كمصدر لإعادة الإعمار، ضرورة حتمية لا مناص منها لانتشال سوريا من هوة الانهيار الذي أطبق على أنفاسها. فبعد سنوات من التآكل البنيوي العميق، الناجم عن مزيجٍ مركب من السياسات الخانقة التي انتهجها نظام الأسد، والعقوبات الغربية، والعزلة الإقليمية، بات من الملح تبني نموذج اقتصادي متسارع الخطى، لعل أبرزه كان إعلان سوريا عن خططها لطباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة خلال السنوات الماضية. وهذا بحد ذاته انعكاس لإعادة التموضع الجيوسياسي في التحالفات الاقتصادية ونهاية النفوذ الروسي داخل المؤسسات المالية السورية، في مقابل انفتاح على شراكات جديدة خليجية وأوروبية تحديداً، يُراد لها أن تكون شركاء حصريين في المرحلة المقبلة بلا الصين وروسيا، والاتفاقات وصلت إلى الموانئ أكثر القطاعات المرغوبة للأخيرين حيث وقعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة ” DP World” الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس.
وعلى الرغم أن هذا النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الجديدة يبدو الطريق الوحيدة، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر. فإن لم يُضبط الانفتاح بأطر تنظيمية وتشريعية واعتبارات اقتصادية تحمي أولويات التنمية، قد يتحول إلى مسار ارتدادي يخلق التبعية لرؤوس الأموال الكبرى. وهنا، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية التي تعد من أكثر النماذج المجاورة دلالة على هذا النوع من الانهيارات المقنعة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، روج حينها لمشهد بيروت العائد، والأبراج الزجاجية و”وسط المدينة” بوصفها مؤشرات نهضة، لكنها كانت مجرد واجهة براقة لأزمة اقتصادية هيكلية، حيث تمثل الانفتاح الاقتصادي هناك في شكل مشروع إعادة إعمار ضخم، قاده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قام على الاقتراض الخارجي الكثيف، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، واعتماد مفرط على قطاعي العقارات والخدمات والمصارف، مع تهميش كامل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وتضخم دور المصارف كأداة تمويل للدولة بفوائد خيالية، إلى أن انفجرت الفقاعة عام 2019، وانهار النظام المالي، وانكشفت هشاشة النموذج. في المقابل، في رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت الدولة على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الزراعة والموارد المحلية، وتم توجيه الاستثمارات إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا، لا إلى بناء مراكز تسوق أو واجهات نفعية.
في الحالة السورية، لا يمكن إنكار وجود فرص موضوعية حقيقية. فإلى جانب ما تملكه البلاد من موارد طبيعية، وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، وإرادة سياسية، تمتلك سوريا قاعدة من الكفاءات والخبراء، وشبكة واسعة من المغتربين القادرين على المساهمة في بناء نموذج اقتصادي متفرد. إلا أن ترجمة هذه الفرص إلى واقع فعلي يتطلب أكثر من مجرد تفاؤل أو رفع عقوبات، بقدر ما يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة، تقوم على الإنتاج لا الريع، وعلى المساءلة لا الحماية، وعلى الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
فعند الحديث عن محاولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي متقدم مثل النموذج السنغافوري، الذي يُطرح أحياناً كإطار طموح لسوريا المستقبل، لا يمكن أن تتحقق ما لم تحدد الأولويات بدقة، وعلى رأسها إعادة بناء القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية استراتيجية، لخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الغذائي والاقتصادي. كذلك الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة يتطلب أيضاً تفكيك شبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي ترسخت في سنوات الصراع وابتلعت الموارد خارج أي رقابة مؤسساتية.
وفي سياق الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، يجدر التذكير هنا بما جرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي عاشت في التسعينيات موجة الخصخصة الصادمة، حين بيعت أصول الدولة من مصانع وشركات وقطاعات حيوية بأسعار زهيدة لمستثمرين خارجيين ولأفراد من نخبة محدودة، تحولت لاحقاً إلى طبقة الأوليغارشيا. تلك التجربة أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية وانتقال القرار الاقتصادي إلى أيد يصعب محاسبتها، وفقاً لحق ملكيتها واحتكارها.
من هذا المنطلق، على سوريا أن تتفادى الوقوع في هذه الأفخاخ، لا سيّما وأن ملامح المرحلة الحالية تحمل ظروفاً أولية لكل الحالات المشابهة الناجحة والمتعثرة. وكما يعاد رسم العقد السياسي في هذه المرحلة، فإن الفرصة متاحة بل مستحقة لكتابة العقد الاقتصادي الذي يحفظ للبلاد سيادتها الاقتصادية ويحقق للسوريين العدالة الاجتماعية تلك التي منتهى حلم الثورات.
المدن
————————-
فورد وروبيو: أميركا المتحمّسة للاستحواذ على مستقبل سوريا
الخميس 2025/05/22
لم تكن المرّة الأولى التي يخرج بها السفير الأميركي السابق إلى سوريا، روبرت فورد، بموقف يثير الكثير من الجدل. في ظل تحولات كبيرة وكثيرة غالباً ما كانت تخرج من الولايات المتحدة الأميركية مواقف أو تسريبات أو تصريحات تنسب إلى مسؤولين أميركيين تحدث جدلاً وتخلط الأوراق. بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، جاء كلام فورد بالتوازي مع شرح مفصل قدمه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام الكونغرس، لخلفيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن دمشق، والتعامل بإيجابية مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وإعطاء سوريا فرصة جديدة.
موقف وزير الخارجية الأميركي نُقل بطريقة تحمل الكثير من الالتباسات، خصوصاً عندما نقل عنه أن سوريا مقبلة على حرب أهلية أو تفكك للدولة وللمجتمع، علماً أن تصويب الموقف جاء ليشير إلى أن هذا العرض كان في معرض تبرير خطوة رفع العقوبات.
يقول فورد “دعتني مؤسسة بريطانية غير حكومية، متخصصة في حل الصراعات، من أجل مساعدتهم في إخراج هذا الشاب (يُشير إلى صورة الشرع حين كان عضواً في تنظيم القاعدة) من عالم الإرهاب وإدخاله إلى عالم السياسة التقليدية”. وأردف الدبلوماسي الأميركي السابق قائلاً: “وعلي أن أخبركم أنني في البداية كنت متردداً جداً بالذهاب، وتخيلت نفسي مرتدياً بدلة برتقالية والسكين على رقبتي، لكن بعد أن تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين خاضوا التجربة وأحدهم قابله (الشرع) شخصياً قررت أن أجرب حظي”.
وتابع فورد قائلاً: “عندما التقيته للمرة الأولى، حين كان اسمه الحركي الجولاني، لكن اسمه الحقيقي الذي لم يكشف عنه إلا بعد السيطرة على دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل حوالى 5 أشهر هو أحمد الشرع، جلست بجانبه بمثل قربي الآن إلى روي (رئيس مجلس بالتيمور) وقلت له باللغة العربية: خلال مليون سنة لم أكن أتخيل أنني سأكون جالسا بجانبك… ونظر إلي وتحدث بنبرة ناعمة قائلاً: ولا أنا”.
بدا الكلام وكأنه إيحاء برغبة من فورد لإظهار دوره ودور مؤسسات دولية أخرى في التأسيس لحقبة الشرع، وتحضيره لاستلام قيادة سوريا. ربما أراد من وراء ذلك نسب الدور لنفسه، أو للولايات المتحدة الأميركية. وذلك في إطار محاولة للالتفاف على كل القوى الإقليمية والدولية التي تعتبر نفسها معنية بإنجاح التجربة السورية الجديدة، وفي ظل الانفتاح على سوريا. تبدو الصورة وكأن واشنطن تريد أن تتصدر المشهد وحدها، وأن يكون رفع العقوبات عن دمشق هو من ضمن السياق الأميركي وليس بناء على جهود دولية أو عربية أخرى بذلت في سبيل ذلك.
لا شك أن كلام فورد من شأنه أن يعزز منطق “المؤامرة” الدولية، التي حاول نظام بشار الأسد ترسيخها لدى الرأي العام السوري، العربي والدولي. بمعنى أن جهات دولية أميركية وبريطانية بالتحديد هي التي عملت على إثارة الثورة، ورعاية قوى مختلفة فيها، تمهيداً لتسليمها السلطة عندما يحين الوقت المناسب بالنسبة إليهم. هنا تجدر العودة سنوات إلى الوراء وإلى بدايات الثورة السورية، عندما اقترف فورد خطأ قاتلاً، إثر زيارته إلى حمص وحماه في العام 2011 وعقد لقاءات مع المتظاهرين والثوار. في حينها اتخذ نظام الأسد من زيارته ذريعة للقول إن التظاهرات تحصل بإشراف ورعاية من قبل الأميركيين.
موقف فورد في سوريا، له الكثير من المواقف التي تشبهه في لبنان لديبلوماسيين أميركيين. من أبرز هؤلاء كان السفير جيفري فيلتمان، والذي كان متحمساً إلى حدود بعيدة لقوى 14 آذار في فترة ثورة الأرز. في حينها، كان فيلتمان يقدم دعماً ووعوداً لهذه القوى في إطار مواجهة حزب الله، وصولاً إلى أحداث 7 أيار 2008 والتي اجتاح خلالها حزب الله لبيروت، بينما كانت الوعود الأميركية بمنع الحزب من ذلك، وتوفير كل الدعم اللازم لإنهاء مسألة سلاحه. أدى خطأ فيلتمان إلى تعزيز سطوة حزب الله أكثر على لبنان، في مقابل خسارة المشروع المضاد، وصولاً إلى حصول تقاطع أميركي إيراني في لبنان تُرجم أكثر فأكثر في سوريا والعراق طوال السنوات الفائتة، لا سيما لدى الوصول إلى الاتفاق النووي في العام 2015.
لا يمكن فصل موقف فورد، وكلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إطار مواصلة المزيد من الضغوط الأميركية على سوريا، لدفعها إلى السلام مع إسرائيل وتخويفها من الحرب الأهلية الداخلية أو من الانهيار. يتزامن ذلك مع حماسة أميركية للاهتمام بسوريا الجديدة القريبة من الغرب، بالإضافة إلى تدفق الكثير من المشاريع والاستثمارات إليها، في ظل الهجمة الكبرى على الاستثمار في المرافق والموانئ وفي القطاعات الزراعية والنفطية.
في موازاة هذه المواقف أو التسريبات، تشير مصادر متابعة إلى أن المسار السوري الأميركي لا يزال يحرز تقدماً، وفي ظل تشديد الأميركيين على إيجاد حلّ لمعضلة المقاتلين الأجانب. فبحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ”المدن”، هناك اتجاه إلى عدم إدخال أي مقاتل أجنبي في مؤسسات الدولة، كما أن الضباط الكبار الذين تم منحهم الجنسية السورية وعينوا بمناصب عالية سيحالون إلى التقاعد قريباً. كما سيتم إخراج الكثير من المقاتلين من سوريا إلى دول أخرى من بينها أفغانستان.
المدن
——————————————
ترامب كاره الحريات… كانت أميركا تبتز حكّامنا بها/ دلال البزري
22 مايو 2025
بالسرعة التي يجيدها دونالد ترامب، وصلت الولايات المتحدة إلى حافّة الاستبداد. الأميركيون خائفون، يراقبون كلّ كلمة ينطقها الواحد منهم، فيبدون اليوم أقرب إلى سكّان عالمنا المطحون. فماذا حقّق ترامب منذ تنصيبه قبل أربعة أشهر؟… بمراسيمه الخاصّة، ألغى الحقّ في التظاهر، وخصوصاً من أجل فلسطين. مئات من الطلاب شاركوا فيها، استُهدفوا بالترحيل أو بالاحتجاز في “مراكز”، هي في الواقع سجون. خاض ترامب (وما زال) معارك مع الصحافة، فهاجم الصحافيين المستقلّين، وأقام دعاوى ضدّهم، وقطع عنهم التمويل الحكومي، وأملى عليهم قواعده الخاصّة. أضعفَ سلطة القانون بتجاهله قرارات قضاة خالفت مراسيمه، بتهديدهم، بل باعتقال قاضيةٍ عارضت أحد إجراءاته غير القانونية. ثمّ هاجم المحامين، وابتزّهم، ونال من الذين أقاموا عليه دعاوى الاغتصاب والاحتيال، فأرغمهم على العمل مجّاناً لقضاياه الشخصية، كالعبيد. أغلق كلّ البرامج الخاصّة بالحريات والمساواة، وأوقف برامج الحريات المخصّصة للخارج. هدد بقطع تمويل الجامعات المعروفة بمناهضتها التمييز العنصري، عزّزه بكلام عنصري صريح ضدّ السود والأقلّيات الأخرى. انتهك حقوق النساء والمختلفين جنسياً، وحقوق المهاجرين القانونية بالعيش في أميركا. ففصل بين العائلات، بين الأولاد وآبائهم وأمّهاتهم. أنذر خصومه السياسيين بالملاحقة والعقاب، بمن فيهم مرشّحون ديمقراطيون، والرئيس السابق جو بايدن نفسه.
وقد تمكّن من ذلك بفضل مراسيم سريعة أيضاً، وقّعها فور تنصيبه، الواحد تلو الآخر، بها وسّع من صلاحياته الشخصية، وخالف القانون والدستور، وبثّ الرعب في قلوب الموظّفين الحكوميين، وأزاح من لا يعجبه واستبدل بهم موالين له. وينكّب الآن على تطوير مشروعه المسمّى “مؤسّسة التراث”، غرضها تقليص الفصل بين السلطات، ومنح كلّ السلطات للرئيس، أي له. وهو مفتون بالرؤساء الدائمين؛ بعض أسلافه دافعوا عن الديكتاتوريين مثل أيزنهاور ونيكسون وريغان. ولكن، ولا واحد منهم عبّر عن ميله هذا صراحةً. في عهده الأول، كان يسترسل في “حبّه” فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي وكيم جونغ أون. وفي عهده الثاني صار يحلم بأن يصبح مثلهم، فعبّر عن رغبته بالتمديد لرئاسته، ما يخالف الدستور الأميركي. كرّرها مرّات، وجملته الشهيرة إنه ليس هو الراغب إنما “كثيرون يريدون أن أفعل ذلك”، منهم مستشاره السابق ستيف بانون، الذي أعلن أنه يمتلك أربع أو خمس طرق للتمديد لرئاسته، يسمّيها “مفاتيح”، عارضاً عليه النصائح الدستورية اللازمة. وكما بتنا نعرف عن سلوكه، بعد هذا الإعلان، أبقى التمديد احتمالاً غائماً، ملتبساً، أو سيفاً مسلّطاً فوق رقاب الجميع، من خصوم وأصدقاء.
والديستوبيا، عكس اليوتوبيا، باتت الكلمة الأكثر تداولاً لوصف الخراب المقبل الشامل الذي هيأ أرضيّته ترامب في مختلف مجالات الحياة الأميركية. الديستوبيا تصف مجتمعاً “كارثياً” في المستقبل القريب، يكون أحد مجالاتها، أيّ الحريات، قد تآكل واشتدّ القمع في حقّ المعارضين، الذين تحوّلوا أكباش فداء لأيّ خراب تكون سياسته سبباً له. بهذه الروحية، وبهذا المزاج، زار ترامب الخليج مستعرضاً، على هامشها، أو في صلبها، بحسب زاوية نظرك، كان ذاك الإعجاب الفائق بولي العهد السعودي محمّد بن سلمان: إنه “رجل غير معقول”، “قائد عظيم”، “أحبّه كثيراً، أحبّه فعلاً كثيراً”. وفي كلمة أمام المستثمرين العالميين، دان ترامب “التدخّل الغربي في بناء الأمم”، و”عشرات السنوات من التدخّل الأميركي في الشرق الأوسط” من أجل الحريات، ووعد بأن “الولايات المتحدة لن تعطي دروساً حول طريقة الحياة” لغيرها من الأمم، واستنكر ما يفعله “الذين يتدخّلون في مجتمعات معقّدة، لا يفهمونها أصلاً”، غامزاً ولامزاً بحقّ أسلافه، خصوصاً بايدن، داعياً سكّان هذه المجتمعات إلى أن “يُحدّدوا مصيرهم على طريقتهم”.
ومن طرائف ردّات الفعل على هذه الكلمات ما كتبه أحد المغرّدين السعوديين في “إكس”، إن ترامب هنا يتكلّم كما لو كان فرانز فانون، المناضل والكاتب المارتينيكي، الداعم للثورة الجزائرية، ولكلّ حركات التحرّر في العالم في ستينيّات القرن الماضي وسبعينياته.
وترامب لم يتوقّف عند هذه النقطة. الأهم ربّما في هذه الزيارة كان لقاؤه برئيس سورية أحمد الشرع، بحضور محمّد بن سلمان. بعيد هذا اللقاء، أسهب ترامب في مديح الشرع أيضاً: إنه “رجل شابّ وجذّاب”، إنه “قوي البنية”، رجل “واعد”. الموضوع؟… إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، أي تدعيم حكم الشرع. وهذا مطلبه، ومطلب الأوروبيين والعرب. العقوبات كما نعلم قائمة منذ حكم الأسد الأب، تزايدت بعد الثورة السورية ضدّ الابن. كانت ذريعتها الدفاع عن الحريات، ولكنّها في الواقع أفقرت السوريين بغالبيتهم، وحقّقت أرباحاً عاليةً لأولئك الذين انتهكوها.
ماذا يريد ترامب من الشرع في مقابل رفع هذه العقوبات؟… لا شيء جدّياً غير “التطبيع مع إسرائيل”، وملحقه “محاربة الإرهاب” و”الوجود الفلسطيني في سورية”. والموضوع ليس جديداً. الاتصالات التي تسرّبت إلى العلن بين موفدين من الشرع والإسرائيليين تجعل الطلب الأميركي مقدوراً عليه، ولكن على الطريقة العربية المعطوفة على الترامبية الآن، يتركها في مجال الالتباس والهمهمة، وبالونات الاختبار، من نوع اعتقال فلسطينيين في منظّمات فلسطينية، أو من هيئة تحرير الشام عندما كان أحمد الشرع هو أبو محمّد الجولاني، ثمّ إطلاق سراحهم. وقد ينضج ظرف الإعلان الرسمي عن تلبية الطلب الأميركي، بعدما يكتمل الاحتلال الإسرائيلي لجبل الشيخ وللأراضي الجديدة المحتلّة أخيراً، ناهيك عن هضبة الجولان. الجولان الذي نسيناه، وتحتلّه إسرائيل منذ 1967، ضمّته إليها عام 1981 بـ”قانون الجولان”، ولم يعترف أحد في العالم بهذا الضمّ إلا ترامب في ولايته الأولى عام 2019.
هكذا، بهذه السياسة المتحرّرة من التزام بالديمقراطية، ولو صورياً، ولو على سبيل الابتزاز، تعيش سورية معادلةً صفريةً؛ أيام الديكتاتور الدموي كانت الحريات تُسحق بحجّة النضال من أجل التحرّر الوطني. والآن، تهاوى التحرّر الوطني، وصارت الديمقراطية أضغاث أحلام، أو وسوسة شيطان.. الآن، لا تحرّر وطني، ولا حرّيات، ولا عزاء للاثنين.
العربي الجديد
———————————
الغارديان: كيف ولدت فكرة “برج ترامب” في دمشق وما هي فرص تحقيقه بعد رفع العقوبات؟
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده ويليام كريستو، شرح فيه كيف ولدت فكرة بناء “برج ترامب” في دمشق. وقال إن الفكرة قامت على بناء برج بارتفاع خمسة وأربعين طابقا وكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار، وكلمة “ترامب” محفورة بالذهب على قمته.
وهذا هو برج ترامب دمشق، وبمثابة نصب تذكاري براق يهدف إلى إعادة سوريا التي مزقتها الحرب إلى الساحة الدولية. وكما تشير الحروف الذهبية، صمم المبنى البراق لجذب الانتباه: انتباه الرئيس الأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة تايغر ومقرها في الإمارات وتقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، والتي تطور برج ترامب: “هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصةً خلال السنوات الـ15 الماضية من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام”.
وتضيف الصحيفة أن مقترح بناء البرج قدم للتقرب من الرئيس الأمريكي، في ظل سعي الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن. وتزامن ذلك مع عرض بمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى ضمانات لأمن إسرائيل.
وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع الدامية التي شنها الرئيس السابق، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة جماعات المعارضة المسلحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلا أن الولايات المتحدة أبقت على العقوبات المفروضة على البلاد، بسبب مخاوفها من الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين.
وتضيف الصحيفة أن المقترح السوري إلى جانب دفعة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان نجحت. فقد أعلن الرئيس ترامب أثناء زيارته للرياض، أنه سيوقف كل العقوبات المفروضة على سوريا، والتقى مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووصفه بالرجل “الجذاب” و “الصعب”.
والآن، وبعد رفع العقوبات وتوطيد العلاقات مع واشنطن، يمكن لبرج ترامب أن ينتقل من التصميم إلى أرض الواقع.
وتضيف الصحيفة أن الزعبي سيزور دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي والحصول على تراخيص بناء البرج العملاق. وقال: “ندرس عدة مواقع، نقترح بناء 45 طابقا قابلة للزيادة أو النقصان حسب الخطة”. وأضاف أن تكلفة بناء البرج التجاري ستتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار. وبعد حصوله على رخصة البناء، سيحتاج الزعبي إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية للحصول على حقوق الامتياز.
ولا تتضمن صور نموذج المبنى، التي اطلعت عليها صحيفة “الغارديان” شعار ترامب، إذ لا يزال الحصول على رخصة الامتياز قيد البحث. وقدر الزعبي أن عملية البناء ستستغرق ثلاث سنوات بعد حصوله على الموافقات القانونية من الحكومة السورية وحقوق مؤسسة ترامب التجارية.
مع ذلك، لا تزال هناك عقبات، إذ لا تزال عملية رفع العقوبات غير واضحة، في حين أن الاقتصاد السوري المتدهور والبيئة السياسية الهشة قد تعقد المشروع. ويستعين رجل الأعمال السوري- الإماراتي بتجرية بناء برج ترامب في اسطنبول، وقد بنى 270 مشروعا في معظم أنحاء الشرق الأوسط. وهو الآن بصدد بناء برج تايغر سكاي في دبي، وهو مشروع بقيمة مليار دولار يزعم أنه يضم “أعلى مسبح لا متناهي في العالم”. كما التقى الزعبي مع الشرع في كانون الثاني/ يناير قبل تعيينه رئيسا لسوريا.
وتقول الصحيفة إن فكرة بناء برج ترامب في دمشق ولدت في كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بعدما أشار النائب الجمهوري جو ويلسون للفكرة في خطاب له أمام الكونغرس. ونقلت الصحيفة عن رضوان زيادة، الكاتب المقرب من الرئيس السوري قوله: “كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب”، واقترح على الزعبي فكرة بناء برج ترامب، وبدأ الاثنان العمل على المشروع.
كان هذا النهج جزءا من حملة تسويقية متعددة الجوانب تهدف إلى وضع سوريا على أجندة ترامب، وبخاصة أنه لم يدل بتصريحات تذكر بشأن سوريا عند توليه منصبه، وبدا الطريق إلى رفع العقوبات الذي تديره وزارة الخارجية، طويلا. وقد استضاف الرئيس السوري رجال أعمال أمريكيين وأعضاء من الكونغرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون النظام السابق والقرى المسيحية المحيطة بالعاصمة.
كما التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء مقربين من إدارة ترامب أثناء زيارته للأمم المتحدة في نيويورك.
ومع استمرار الدبلوماسية، بدا مشروع “برج ترامب” وسيلة لاستمالة الرئيس الأمريكي وطريقة تعامله غير التقليدية في طمس الحدود بين مملكة عائلته التجارية ومنصبه السياسي وبخاصة في الشرق الأوسط. وقدم زيادة نموذجا للبرج المقترح إلى الشيباني في نيسان/ أبريل والذي “أبدى تحمسا شديدا له”، وقدمه أيضا للسفير السعودي في دمشق، على أمل أن يراه فريق ترامب. وقال زيادة: “هكذا تكسب قلبه وعقله”.
وتشير الصحيفة إلى أن ثقته باستراتيجيته زادت بعد أن نشر ترامب مقطع فيديو في شباط/ فبراير يظهر برج ترامب في غزة كجزء من مقترحه المثير للجدل لتهجير الفلسطينيين فعليًا وبناء ريفييرا فاخرة في الأراضي الفلسطينية.
وإلى جانب كسب القلوب والعقول في الولايات المتحدة، يأمل السوريون أن يجذب مشروع عقاري ضخم مثل برج ترامب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا. ذلك أن البلد بحاجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة. وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، ويقضون معظم يومهم بدون كهرباء أو رعاية طبية مناسبة.
—————————————-
ما مدى سرعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية عن سوريا؟
2025.05.23
يدور نقاش داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أن قرر الأخير إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا منذ نحو نصف قرن، حول مدى السرعة والشمولية التي ينبغي أن يُنفّذ فيها ذلك القرار.
فرض رؤساء الولايات المتحدة على مر السنين عقوباتٍ مُتراكمة على العائلة المُستبدة التي كانت تُسيطر على سوريا سابقاً، وكان من الممكن رفعها أو إلغاؤها بسرعة من خلال قرارٍ تنفيذي. لكن الكونغرس فرض بعضاً من أشدّ الإجراءات صرامةً، وسيتعين عليه إلغاؤها نهائياً، وفق تقرير نشرته اليوم الجمعة وكالة “أسوشيتد
برس” الأميركية.
يقول الرئيس السوري أحمد الشرع إنه يعمل على بناء حكومة شاملة صديقة للغرب. ويسعى بعض مسؤولي إدارة ترامب إلى رفع العقوبات أو التنازل عنها بأسرع وقت ممكن دون فرض شروط صارمة أولاً.
“رفع تدريجي للعقوبات”
مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية اقترحوا نهجاً تدريجياً، يُمنح بموجبه إعفاءات قصيرة الأجل قريباً من بعض العقوبات، ثم يُربط التمديد أو إصدار أمر تنفيذي أوسع نطاقاً باستيفاء سوريا للشروط، مما قد يُبطئ بشكل كبير -أو حتى يمنع بشكل دائم- تخفيف العقوبات على المدى الطويل. ويقول المنتقدون إن ذلك من شأنه أن يُعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات وإعادة إعمار سوريا بعد الحرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن “العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر”.
وقال بلوستين في بيان لوكالة أسوشيتد برس يوم أمس الخميس إن الإدارة “تحلل حالياً الطريقة المثلى للقيام بذلك” وستصدر إعلاناً قريباً.
مسؤول أميركي كبير مطلع على الخطة، والذي لم يكن مخولاً بالتعليق علنا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال إن اقتراحاً من وزارة الخارجية تم تداوله بين المسؤولين بعد تعهد ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط الأسبوع الماضي يضع شروطاً شاملة لمراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها بشكل دائم، بما في ذلك تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة كمطلب رئيسي.
وأضاف المسؤول أن هناك مقترحات إضافية متداولة، بما في ذلك مقترح تم تداوله هذا الأسبوع أكد على نطاق واسع على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، في أسرع وقت ممكن، للمساعدة في إعادة بناء سوريا.
إعلان أميركي مرحب به في سوريا
رقص الناس في شوارع دمشق بعد أن أعلن ترامب في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أنه “سيأمر بوقف العقوبات ضد سوريا من أجل منحها فرصة العظمة”.
قال ترامب قبل يوم من لقائه بالزعيم الجديد للبلاد: “سنزيلهم جميعاً. حظاً سعيداً يا سوريا. أرنا شيئاً مميزاً”.
هذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى اتباع نهج حذر في شهادته أمام المشرعين الأميركيين. ودعا روبيو إلى البدء في تخفيف العقوبات بسرعة، قائلاً إن الحكومة الانتقالية السورية التي لم يمض على تشكيلها خمسة أشهر قد تكون على بعد أسابيع من “الانهيار وحرب أهلية كاملة النطاق ذات أبعاد ملحمية”.
ولكن عندما سئل روبيو عن الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه تخفيف العقوبات بشكل عام، قدم تفسيراً من كلمة واحدة: “تدريجياً”.
فرضت واشنطن عقوبات على العائلة الحاكمة السابقة في سوريا منذ عام 1979 بسبب دعمها لـ “حزب الله” وجماعات مسلحة أخرى متحالفة مع إيران، وبرنامجها المزعوم للأسلحة الكيميائية ووحشيتها ضد المدنيين بينما كانت عائلة الأسد تقاتل من أجل البقاء في السلطة.
تشمل العقوبات عقوباتٍ صارمةً على الشركات أو المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون مع البلاد. تحتاج سوريا إلى استثماراتٍ بمليارات الدولارات لإصلاح بنيتها التحتية المدمرة ومساعدة ما يُقدّر بنحو 90 بالمئة من السكان الذين يعيشون في فقر.
أقرّ روبيو أمام المشرعين هذا الأسبوع بأن قادة سوريا المؤقتين “لم يجتازوا فحص سجلاتهم لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي”. وكانت جماعة “هيئة تحرير الشام” التي قادها الشرع في السابق، مرتبطةً في الأصل بتنظيم القاعدة، إلا أنها تخلّت عنه لاحقاً واتخذت نهجاً أكثر اعتدالاً. ولا تزال الولايات المتحدة تُدرجها على قائمة المنظمات الإرهابية.
ولكن حكومة الشرع قد تكون الفرصة الأفضل لإعادة بناء البلاد وتجنب الفراغ في السلطة الذي قد يسمح بعودة “تنظيم الدولة” والجماعات المتطرفة الأخرى.
قال روبيو: “إذا تواصلنا معهم، فقد ينجح الأمر وقد لا ينجح. وإذا لم نتواصل معهم، فمن المؤكد أن الأمور لن تنجح”.
وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمجموعة عمل الطوارئ السورية ومقرها الولايات المتحدة والمدافع الذي كان مؤثرا في المساعدة على تشكيل السياسة الأميركية السابقة بشأن سوريا، إنه كان يتداول إطار عمل لأمر تنفيذي مقترح من شأنه أن يسمح لترامب بإزالة العديد من العقوبات بسرعة.
وأكد مصطفى أن خطوة ترامب برفع العقوبات تهدف إلى “منع قيام دولة فاشلة وإنهاء العنف الدائم”، لكن البعض في الإدارة يحاولون “تخفيف” القرار.
النقاش داخل إدارة ترامب
اقترحت الوثيقة الأولية التي أصدرها فريق السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي خارطة طريق من ثلاث مراحل لتخفيف العقوبات، تبدأ بإعفاءات قصيرة الأجل. وسيرتبط التقدم نحو تخفيف إضافي ورفع تام للعقوبات في مراحل لاحقة بشروط صارمة أثارت معارضة بعض المسؤولين.
يُعدّ إبعاد “الجماعات الفلسطينية” من سوريا أول متطلبات المرحلة الثانية. ويقول مؤيدو تخفيف العقوبات إن هذا الشرط قد يكون مستحيلاً، نظراً لطبيعة تحديد الجماعات التي ينطبق عليها وصف “إرهابية”، ومتى يُمكن إعلان إبعادها.
ومن بين الشروط الأخرى للانتقال إلى المرحلة الثانية أن تتولى الحكومة الجديدة رعاية مراكز الاحتجاز التي تضم مقاتلي “تنظيم الدولة” في شمال شرقي سوريا، وتنفيذ الاتفاق الأخير مع “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد” المدعومة من الولايات المتحدة -والتي تدير مراكز الاحتجاز- والذي يتضمن دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.
وللوصول إلى المرحلة الثالثة، يتعين على سوريا الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام -تطبيع العلاقات مع إسرائيل- وإثبات أنها دمرت كل الأسلحة الكيميائية للحكومة السابقة.
سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حثّ إدارة ترامب على عدم رفع العقوبات عن سوريا. وتشكّك إسرائيل في الحكومة الجديدة، رغم أن مسؤولين سوريين صرّحوا علناً بعدم رغبتهم في صراع مع إسرائيل.
منذ سقوط الأسد، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية واستولت على منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة في سوريا.
العقوبات المفروضة من الكونغرس
وفي حين يمكن رفع بعض العقوبات من خلال إجراء تنفيذي، فإن عقوبات أخرى تواجه عملية أكثر تعقيداً.
ولعل الأصعب هو قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو مجموعة واسعة النطاق من العقوبات أقرها الكونغرس في عام 2019 رداً على جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها حكومة الأسد.
إن العقوبات الجديدة تمنع بشكل خاص أنشطة إعادة الإعمار، وعلى الرغم من أنه يمكن التنازل عنها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، فمن المرجح أن يكون المستثمرون حذرين من مشاريع إعادة الإعمار عندما يمكن إعادة فرض العقوبات بعد ستة أشهر.
وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي في تركيا مع وزير الخارجية السوري، أوضح روبيو والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنهما يؤيدان دعوة ترامب لتخفيف العقوبات على الفور، لكن التخفيف الدائم يتطلب اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة السورية لتلبية الشروط التي وضعها الرئيس، وفقا لمسؤولين أمريكيين آخرين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية.
قال غراهام هذا الأسبوع: “لدينا فرصة سانحة هنا لتزويد هذه الحكومة الجديدة ببعض الإمكانيات التي ينبغي أن تكون مبنية على الشروط”. “ولا أريد أن تفوت هذه الفرصة”.
تلفزيون سوريا
——————————
هل تتعلّم سوريا السر من ألمانيا وكوريا؟/ محمد ياسين نجار
22/5/2025
حين تُرفع العقوبات، لا تُفتح فقط الأبواب أمام المال والمشاريع، بل تُطرح أسئلة عميقة: هل يمكن إعادة بناء بلد خرج بعد عقد من الحرب، دون إعادة إنتاج الأسباب التي أوصلته إلى الانهيار؟
إن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس مجردَ إعمار للبنية التحتية، بل تعافيًا سياسيًا ومجتمعيًا يضع الأسس لدولة حديثة عادلة ومشتركة.
إنّ التحولات العميقة في رواندا، وألمانيا، وكوريا، وأميركا، لا تمنحنا وصفات جاهزة، لكنها تكشف كيف يمكن للدول أن تنهض من تحت الركام إذا امتلكت إرادة جماعية ورؤية واضحة. فهي تساعدنا على تمييز ما يُصلح الدول بعد الصراع، وما يُعيدها إلى الدوامة. ومن هنا، نفهم أن الإعمار لا يبدأ من المال، بل من الإصلاح والمؤسسات.
تجارب الفشل: حين يُبنى الإعمار على الطائفية والإنكار
العراق
بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، خُصصت مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار، لكن النتائج كانت كارثية. غابت الرؤية الوطنية، وهيمنت المرجعيات الدينية على المشهد السياسي، وتشكّلت مليشيات طائفية موازية لمؤسسات الدولة تُدار من الخارج، ما أدى إلى تآكل السلطة المركزية.
تزامن ذلك مع انتشار واسع للفساد المالي والإداري، وغياب أي مساءلة حقيقية، مما حوّل الإعمار إلى أداة تعميق للانقسام بدل أن يكون وسيلة لتجاوزه.
لبنان
تجربة إعادة الإعمار بقيادة الرئيس رفيق الحريري بعد الحرب الأهلية بدت واعدة في بدايتها، لكنها افتقرت إلى استقلالية القرار الوطني، الذي كانت تهيمن عليه آنذاك أجهزة المخابرات السورية، بالإضافة إلى غياب إصلاح جذري في بنية الدولة.
تركّز الجهد بشكل مفرط على دور الحريري كمحرّك للإعمار، على حساب بناء مؤسسات فاعلة ومستقلة. تم التركيز على البنيان العمراني، فيما غابت المحاسبة والشفافية، واستُبدلت الدولة بشبكات مصالح طائفية، ما أدى لاحقًا إلى انهيار شامل في مؤسسات الدولة ومقوماتها الاقتصادية.
كما تكشف لنا التجارب السابقة: لا يمكن بناء دولة عادلة ما لم تتوفر مصالحة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، وهوية وطنية جامعة، وفي حال التغاضي عما سبق فإن أي مشروع إعمار لن يكون إلا استراحة قصيرة في طريق أزمة أعمق.
تجارب النجاح: من رماد الدمار إلى نهضة الدول.. كيف نجحت رواندا وكوريا وألمانيا وأميركا؟
رواندا
خرجت من إحدى أفظع الإبادات في القرن العشرين، لكنها اختارت طريق المصالحة الجماعية بدل الثأر. أنشأت محاكم شعبية (غاتشاكا)، وركزت على التعليم، وتمكين المرأة، واستخدام التقنية والحكومة الإلكترونية. فنجحت في التحول من دولة فاشلة إلى واحدة من أكثر الدول كفاءة في أفريقيا.
ألمانيا الغربية
بعد الحرب العالمية الثانية، كانت البلاد مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا. لكن تجربة مشروع مارشال فيها لم تكن ناجحة بسبب المال، علمًا بأنها ليست أكثر المستفيدين أوروبيًا منها، بل لأن الشعب الألماني امتلك مشروعًا للإصلاح وإعادة البناء. ارتبط الدعم الخارجي بحكومة شرعية، ومؤسسات منتخبة، وقانون صارم ضد الفساد. ويُعزى تميز النجاح الألماني مقارنة بدول أوروبية أخرى إلى عدة عوامل:
وجود قاعدة صناعية وتعليمية متقدمة نسبيًا قبل الحرب.
تمكين القيادة المحلية من إدارة الدعم بدل فرضه من الخارج.
البيروقراطية الفعالة.
الإرادة الشعبية الواضحة للنهوض من جديد.
كوريا الجنوبية
بعد الحرب الكورية، كانت من بين أفقر دول العالم. لكنها اختارت طريق التنمية من خلال التعليم، والإصلاح الزراعي، والتصنيع الموجه للتصدير. بدعم من الدولة، نشأت شركات وطنية كبرى واستثمرت في الإنسان قبل البنيان، مما مهّد لتحولها إلى قوة اقتصادية عالمية.
ما تعلّمناه من التحولات الكبرى الناجحة: التنمية ليست منحة خارجية، بل رؤية داخلية. إعادة الإعمار الناجحة تبدأ من الإنسان، ومن الثقة بين الدولة والمجتمع، ومن العدالة، قبل أن تبدأ من التمويل أو العقود.
ما الذي تحتاجه سوريا؟
سوريا لا تحتاج فقط إلى أموال أو مؤتمرات، بل إلى رؤية وطنية جذرية تُرسي أسس الدولة الجديدة على أربعة محاور مترابطة:
هيئة وطنية مستقلة لإدارة الإعمار: تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وتخضع لمجلس رقابي متعدد التمثيل وبرلمان محترف فاعل، مما يضمن الشفافية التامة في التمويل والتنفيذ.
مصالحة وطنية عميقة: لا تستند إلى تسويات فوقية، بل إلى حوار مجتمعي شامل يشمل جميع الضحايا والفاعلين، وتؤطره آليات العدالة الانتقالية والمساءلة.
اقتصاد إنتاجي وتنمية متوازنة: يقوم على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعليم المهني، والزراعة والصناعة، والانتقال إلى اقتصاد حيوي لا رَيعي.
سيادة وطنية وشراكات نزيهة: الانفتاح على التمويل الخارجي يجب ألا يتحول إلى وصاية سياسية، بل إلى شراكات إستراتيجية تحفظ القرار الوطني.
وفي الوقت ذاته، من الضروري أن يعي كل من يعوّل على الخارج أو يراهن على تدخلاته، أن هذا الخيار لم يكن يومًا مسارًا ناجحًا لبناء الأوطان. فالتجارب القاسية في الإقليم والعالم أثبتت أن الاستقرار لا يُستورد، وأن التنمية الحقيقية لا تُبنى على انتظار الخارج، بل على إرادة الداخل.
خاتمة
رفع العقوبات لا يعني بالضرورة بداية التعافي، بل هو فرصة مشروطة. نجاحها يتوقف على خيارات الداخل أكثر من الخارج. سوريا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تختار طريق رواندا، وألمانيا، وكوريا في لحظاتها التحولية، فتنهض ببطء ولكن بثقة، أو تعيد تكرار أخطاء العراق، ولبنان فتُغرق نفسها في دوامة جديدة.
لكن ما تحقق حتى الآن ليس بالقليل: من التحرير العسكري لأجزاء واسعة من البلاد، إلى تعزيز الانفتاح الإقليمي، وصولًا إلى رفع العقوبات. كلها مؤشرات على أن مشروع الدولة السورية الجديدة يسير بثبات نحو استعادة السيادة والفاعلية.
وتبقى إحدى المهام المصيرية أمام القيادة اليوم هي استكمال استعادة وحدة الأراضي السورية، لا سيما في شمال شرق البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتشكيل البرلمان الفاعل، بما يعزز الشعور الوطني ويؤسس لبيئة سياسية واقتصادية مستقرة.
ويبقى السؤال: هل تنجح القيادة؟ وفي مقدمتها الرئيس الشرع في إنجاز المهام الكبرى القادمة من إعادة بناء المؤسسات، وتحقيق العدالة إلى إطلاق تنمية حقيقية؟
إنها لحظة كتابة التاريخ مجددًا لا ترميمه، إعادة الإعمار ليست إعادة بناء لما كان، بل رؤية إبداعية لما يجب أن يكون.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
وزير سابق في الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية
الجزيرة
—————————————–
سوريا الجديدة: تحولات ما بعد العقوبات/ عبد اللطيف البصري
22/5/2025
تمثل مرحلة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا -بعد سقوط النظام المخلوع وتسلّم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم- نقطة تحول محورية في تاريخ البلاد المعاصر.
فهذا التطور لا يعكس مجرد تغيير في السياسة الخارجية الأميركية، بل يشير إلى اعتراف دولي بالتحولات العميقة التي شهدتها سوريا على المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي متغير، يتطلب فهمًا عميقًا لدلالاتها وتداعياتها المستقبلية.
السياق التاريخي للعقوبات
فُرضت العقوبات الأميركية على سوريا على مدى عقود طويلة، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق.
لم تكن هذه العقوبات مجرّد إجراءات اقتصادية، بل مثّلت أداة سياسية هدفت إلى عزل نظام اتُّهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وقد شكلت هذه العقوبات جزءًا من منظومة ضغط دولية، استهدفت تغيير سلوك النظام السابق، لكنها أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد السوري والمواطنين العاديين. وبالتالي، فإن رفعها اليوم يمثل اعترافًا ضمنيًا بالتغيير الجذري في بنية النظام السياسي السوري.
الأبعاد السياسية للانفتاح الجديد
يحمل قرار رفع العقوبات دلالات سياسية عميقة، أبرزها الاعتراف الدولي بشرعية النظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع؛ فالولايات المتحدة، من خلال هذا القرار، تقدم إشارة واضحة بأنها ترى في سوريا الجديدة شريكًا محتملًا في المنطقة، وليس خصمًا يجب احتواؤه.
كما يعكس هذا القرار تحولًا في الإستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات مع الدول التي تتبنى مسارات إصلاحية، وهذا يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى المشهد الإقليمي والدولي كفاعل مؤثر.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الغربية، وإعادة فتح السفارات، وتنشيط قنوات التواصل السياسي، ما يسهم في كسر العزلة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة.
التداعيات الاقتصادية المرتقبة
تفتح هذه المرحلة الجديدة آفاقًا واسعة للاقتصاد السوري الذي عانى من الركود والانهيار خلال سنوات الصراع والعقوبات؛ فرفع العقوبات يعني إمكانية استئناف التعاملات المصرفية الدولية، وعودة الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السورية.
كما يتيح هذا التطور فرصة للحصول على قروض وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم برامج إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية المتضررة. ويمكن أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف معدلات الفقر المرتفعة.
غير أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، وتبنّي سياسات شفافة في إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية
على المستوى الاجتماعي، يمكن أن يسهم رفع العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين السوريين، من خلال توفير السلع الأساسية والأدوية، التي كانت شحيحة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. كما يمكن أن يساعد في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يشجع هذا الانفتاح على عودة اللاجئين والمهجرين السوريين من دول الجوار وأوروبا، خاصة مع تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية، وهذا يتطلب برامج وطنية لإعادة الإدماج، وتوفير السكن والعمل، وضمان المصالحة المجتمعية.
كما يمكن أن يسهم الانفتاح في تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي يمكنها الآن العمل بحرية أكبر وتلقي الدعم الدولي لبرامجها التنموية والإنسانية.
التحديات والفرص المستقبلية
رغم الإيجابيات المتوقعة، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد العقوبات؛ فالبلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة إرث الانتهاكات السابقة من خلال آليات العدالة الانتقالية.
كما أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة تتطلب موارد ضخمة وخططًا إستراتيجية طويلة المدى. وهناك تحدي إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على قطاعات تقليدية محدودة.
نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها
غير أن هذه التحديات تقابلها فرص واعدة، خاصة مع الدعم الدولي المتوقع، والموقع الإستراتيجي لسوريا، وإمكانية الاستفادة من خبرات السوريين في المهجر.
ويمكن لسوريا الجديدة أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية لبناء نموذج تنموي مستدام، يقوم على المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية.
يمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تحمل في طياتها آمالًا كبيرة وتحديات جسيمة. وتتطلب هذه المرحلة رؤية وطنية شاملة، وإرادة سياسية قوية، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، لتحويل الانفتاح السياسي والاقتصادي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن السوري في حياته اليومية.
إن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها.
وتبقى المسؤولية مشتركة، بين القيادة السياسية الجديدة والمجتمع السوري والمجتمع الدولي، لضمان أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لسوريا ديمقراطية مزدهرة ومستقرة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
مدون، ماجستير دراسات القدس وفلسطين (علاقات دولية
الجزيرة
——————————————-
ترحيب برفع العقوبات: واشنطن تدعو سوريا للسلام مع إسرائيل
الأربعاء 2025/05/21
لاقى قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً داخل مجلس الأمن، مع التأكيد مع وحدة وسلامة الأراضي السورية وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، كما دعا المجلس إلى استجابة دولية شاملة تُسرّع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار.
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة لبحث آخر التطورات في سوريا، تقدم فيها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسين بإحاطة أمام أعضاء المجلس، الذين تقدموا بدورهم بمداخلات، قبل أن تُغلق الجلسة أمام وسائل الإعلام لعقد مشاورات مغلقة بين الأعضاء.
تفاؤل حذر
وفي إحاطته أمام المجلس، قال بيدرسن: “يسود جو التفاؤل الحذر وتطلع إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا”، مؤكداً أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك لدعم الانتقال السياسي السوري.
ورحّب بالدعم الذي قدمته السعودية وتركيا وقطر، بما في ذلك معالجة التزامات سوريا المعلقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ودعم دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير الموارد الحيوية في مجال الطاقة، مشدداً على وجود تحديات هيكلية كبيرة تواجه سوريا، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، وعوامل أخرى المزعزعة للاستقرار.
وأكد أن “إنعاش الاقتصاد المنهار سيتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة تشمل الإصلاح الاقتصادي الشامل ومعايير الحوكمة في النظام المالي، وسيحتاج ذلك إلى دعم دولي”.
وفيما رحّب بتشكيل للجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، أوضح بيدرسن أن “الخطوة التالية الأساسية”، هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، فيما حذّر التصعيد الأخير في مناطق الأغلبية الدرزية في السويداء وضواحي دمشق.
وأعرب عن قلقه الشديد إزاء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، بما في ذلك خلال أحداث العنف في المناطق ذات الغالبية الدرزية وقرب القصر الرئاسي، مشدداً على أن “مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف. ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. هناك فرص دبلوماسية واضحة، ويجب إعطاؤها الأولوية”.
وأكد أن “الشعب السوري شعر بالارتياح لأن قرارات الأسبوع الماضي برفع العقوبات تمنحه فرصة أفضل من ذي قبل للنجاح في مواجهة صعوبات كبيرة”.
العلاقات الأميركية-السورية
وأكدت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدء خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا، مؤكدةً التطلع إلى جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، لإعادة بناء اقتصادها. وقالت إن “إجراءات الحكومة السورية حتى الآن من شأنها رفع سقف توقعاتنا لما سيأتي لاحقاً”.
وقال مندوب واشنطن في مجلس الامن جون كيلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يريد أن يرى سوريا والمنطقة بأسرها تزدهر، “ولذلك اتخذ قراراً جريئاً بشأن سوريا، على أمل أن تغتنم الحكومة الجديدة هذه الفرصة لإعادة الإعمار، وتحويل البلاد من مصدر لعدم الاستقرار إلى مصدر للاستقرار”.
وأضاف أن الوكالات الحكومية الأميركية تعمل حالياً على تنفيذ توجيهات ترامب بشأن العقوبات على سوريا، وإصدار التراخيص اللازمة لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها، ووضع البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.
ودعا الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات “جريئة” وإظهار تقدم مستدام في التوقعات التي أبلغتها الولايات المتحدة، وهي تحقيق السلام مع إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقات “أبراهام”، وإبعاد “المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الجيش السوري بسرعة”، وضمان “عدم تمكن الإرهابيين الأجانب بما في ذلك الميليشيات الفلسطينية، من العمل انطلاقاً من سوريا”.
كما دعا المندوب، الحكومة السورية إلى التعاون مع الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي لمنع عودة ظهور داعش، وتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز عناصره وكذلك مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق البلاد.
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بشأن ملفات حيوية، بما في ذلك تدمير أسلحة بشار الأسد الكيماوية والبحث عن المفقودين الأميركيين والأجانب في سوريا، تبعث على “الأمل”.
المندوب الروسي
من جهته، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة السورية للتحقيق بأحداث الساحل تواصل عملها، مشدداً على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأعرب في كلمته في مجلس الأمن، عن إدانة بلاده للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مشيراً لوجود تقدم ملحوظ في عودة السوريين إلى بلادهم. كما شدد على دعم موسكو، وحدة سوريا وسلامة أراضيها ونحترم اختيار السوريين لتقرير مصيرهم، بينما أكد التزام موسكو، بالتعاون مع الحكومة السورية ودعمها، لافتاً إلى أن العلاقات بين روسيا وسوريا قائمة على الاحترام المتبادل.
المدن
——————————–
هل أعادت زيارة ترامب إلى الخليج تشكيل النظام الإقليمي؟/ هلا نهاد نصرالدين
22.05.2025
زيارة ترامب إلى الخليج 2025 لم تكن مجرد جولة بروتوكولية، بل هي نقطة تحوّل إقليمية ودولية في العلاقات الأميركية الشرق الأوسطية في عهد ترامب. أعادت هذه الزيارة تعريف دور الخليج في المعادلة الدولية كحليف استراتيجي وأساسي للولايات المتحدة الأميركية.
منذ اللحظة الأولى لوصوله، ومع رقصته الشهيرة على سلّم الطائرة، عكست زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى دول الخليج رغبة واضحة في إعادة تعريف التحالفات الأميركية في المنطقة. لا يُخفى على أحد أن ترامب هو رجل أعمال وهمّه “البزنس” والصفقات التجارية المربحة على حساب القضايا الاستراتيجية والإنسانية. لم يقدّم نفسه كرئيس مهتم بالقضايا الإنسانية والحريات. الّا أنّ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم تغب عن الاجتماعات. سعى ترامب إلى طرح مبادرة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف أميركي مباشر بعد الحرب، وتحويله إلى منطقة اقتصادية حرة، إلا أن الدول الخليجية رفضت هذا الطرح، وشددت على ضرورة إعادة إعمار غزة ضمن خطة عربية شاملة دون المساس بحقوق السكان أو فرض إدارة خارجية مؤقتة.
تراجعت مركزية إسرائيل كحليف أوحد، وبرزت دول الخليج كشريك اقتصادي وأمني رئيسي، بخاصة مع تصاعد الدور الجيوسياسي والاقتصادي لهذه الدول. لم يزر ترامب إسرائيل ولم يلتقِ برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته الأولى الى المنطقة، على رغم تأكيد المسؤولين الأميركيين أن ذلك لم يكن تجاهلاً متعمداً، إذ التقى مبعوثه للشرق الأوسط برهينة إسرائيلية أُفرج عنها حديثاً.
حملت هذه الخطوات رسالة واضحة إلى نتانياهو بأن المصالح الأميركية لم تعد مرهونة فقط برغبات تل أبيب – بخاصة مع استمرار الحرب في غزة ورفض نتانياهو وقف إطلاق النار أو الانخراط في أي مسار سياسي – بل باتت ترتبط أكثر بمصالح اقتصادية واستراتيجية مع دول الخليج.
شهدت منطقة الشرق الأوسط في أيار/ مايو 2025، واحدة من أكثر الزيارات الرئاسية الأميركية المثيرة للجدل والتأثير، إذ اختار ترامب أن تكون أولى جولاته الخارجية في ولايته الثانية إلى دول الخليج الثلاث: السعودية وقطر والإمارات، متجاوزاً بذلك تقاليد الرؤساء الأميركيين. لم تكن هذه الخطوة مجرد زيارة بروتوكولية، بل حملت رسائل استراتيجية عميقة متعلقة بإعادة رسم توازن القوى في الشرق الأوسط وصعود الخليج كلاعب مركزي في السياسة الإقليمية والدولية وكحليف أساسي واستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة ينذر بتراجع محتمل لمركزيّة اسرائيل في المنطقة بالنسبة الى الولايات المتحدة الأميركية.
جاءت زيارة ترامب في فترة استثنائية تمر بها المنطقة، مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من عام، إضافة إلى الحرب الأخيرة على لبنان التي آلت إلى هزيمة حزب الله واغتيال أمينه العام حسن نصرالله، ما أدى إلى تغيّر موازين القوى وبدء ما وُصف بـ “عهد جديد” في لبنان وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 فيه، بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
إعادة تشكيل النظام الإقليمي
اعتُبرت جولة ترامب على دول الخليج في الداخل الأميركي بمثابة إعادة تموضع كبيرة وتحوّل جريء في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ تم تقديم العلاقات مع السعودية وقطر والإمارات على التحالف التقليدي مع إسرائيل، لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول الاستقرار الإقليمي، والقيم الأميركية، ومستقبل التحالفات التقليدية. وقد فُسرت الزيارة كرسالة واضحة لنتانياهو بأن إسرائيل لم تعد الحليف الوحيد والأهم للولايات المتحدة في المنطقة، بل بات هناك حلفاء أكثر “منفعة” من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية.
لم تقتصر زيارة ترامب على الدول الخليجية الثلاث، بل التقى أيضاً بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في الرياض، وأبدى إعجابه به ووعد برفع العقوبات عن سوريا، في تحوّل لافت لأولويات السياسة الأميركية في المنطقة. فاعتُبر انفتاح ترامب على سوريا ورفع العقوبات عنها تحولاً كبيراً في السياسة أربك بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. قرار ترامب بعدم زيارة إسرائيل ولقاؤه بالرئيس السوري الجديد في الرياض عزز ا هذا التحول، مشيراً إلى أن المصالح الأميركية باتت تتقدم على أولويات نتانياهو. ومع ذلك، حافظ ترامب على تأكيده العلني لمتانة العلاقات مع إسرائيل، لكنه في الكواليس عبّر عن استيائه من نتانياهو، معتبراً إياه عقبة أمام المصالح الأميركية وجهود إعادة تشكيل المنطقة.
على رغم الزخم الاقتصادي والدبلوماسي الذي رافق الزيارة، إلا أنها لم تخلُ من انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة. فقد اعتبر كثر من المتابعين أن ترامب ركز بشكل مفرط على الصفقات التجارية والمكاسب الاقتصادية السريعة، متجاهلاً القضايا الإنسانية والسياسية الملحّة، بخاصة في غزة واليمن. كما أثيرت انتقادات حادة بشأن تضارب المصالح نتيجة ارتباطاته التجارية الواسعة في الخليج. زادت حدّة الانتقادات عند قبول ترامب هدية عبارة عن طائرة خاصة فاخرة من قطر، وهو ما اعتبره معارضوه تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية ومصدراً محتملاً لتأثير غير مشروع على قراراته.
وبحسب مقال تحليلي للمركز العربي في واشنطن: “أحد الجوانب اللافتة في زيارة الرئيس ترامب للشرق الأوسط، في رحلة مليئة بالمفاجآت، كانت في الواقع ما لم يحدث: التوقف في إسرائيل. معظم الرؤساء الأميركيين لم يكونوا ليفوتوا مثل هذه الفرصة. هذا التجاهل يأتي بعد أحداث أخرى استُبعدت فيها إسرائيل أخيراً، مثل المفاوضات مع الحوثيين لإنهاء الهجمات على السفن الأميركية في البحر الأحمر؛ والمحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ والمفاوضات بين المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وحركة حماس، والتي ربما ساهمت في الإفراج عن آخر رهينة أميركية؛ ورفع ترامب العقوبات عن سوريا ولقائه في الرياض مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي كان سابقاً من كبار قادة القاعدة. إسرائيل عارضت جميع هذه الخطوات، لكن ترامب مضى قدماً فيها على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، فإن إقالة ترامب مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، كانت جزئياً بسبب تنسيقه الوثيق مع حكومة نتانياهو بشأن ضربات إيران، وهو ما يعارضه ترامب في الوقت الحالي.
في الظروف السياسية العادية، أي رئيس أميركي يتبع مثل هذا النهج من تجاهل أو معارضة إسرائيل، كان سيعاني من عواقب سياسية شديدة. لكن يبدو أن ترامب حصّن نفسه ضد الانتقادات التي كانت ستضرّ بأي شخص آخر”.
صفقات اقتصادية غير مسبوقة
أبرز ما ميّز الزيارة هو حجم الصفقات الاستثمارية والتجارية المعلنة، والتي تجاوزت بحسب تقديرات البيت الأبيض تريليوني دولار، فيما قدّرت بما يقارب الـ 4 تريليونات دولار. شملت هذه الصفقات قطاعات الطيران (صفقات تاريخية مع بوينغ)، والدفاع (صفقات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات وقطر)، والتكنولوجيا (مشاريع الذكاء الاصطناعي)، إضافة إلى البنية التحتية والطاقة.
أعلنت السعودية عن حزمة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار، تضمنت صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار في أكبر صفقة أسلحة في العالم. أما الإمارات، فقد أبرمت اتفاقيات بقيمة 200 مليار دولار على المدى القريب، وتعهدت باستثمار 1.4 تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل. بينما وقّع ترامب اتفاقية مع قطر لتحقيق تبادل اقتصادي لا يقل عن 1.2 تريليون دولار. كما أعلن ترامب عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر تزيد قيمتها عن 243.5 مليار دولار، من بينها صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت قطر 10 مليارات دولار في تطوير قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة جوية عسكرية أميركية في قطر والشرق الأوسط، والواقعة جنوب غربي الدوحة. وتعتبر قاعدة العديد:
مركز عمليات القيادة المركزية الأميركية في المنطقة
نقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية في العراق وأفغانستان وسوريا
محوراً رئيسياً للتعاون العسكري بين قطر والولايات المتحدة
يعكس استثمار قطر في قاعدة العديد تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة في مجالي الأمن والدفاع، ويبرز أهمية قطر المتزايدة كمركز إقليمي استراتيجي. ومع ذلك، يثير هذا الاستثمار تساؤلات حول استمرار الوجود والتدخل العسكري الأميركيين في المنطقة.
الالتزامات المالية من السعودية والإمارات وقطر لترامب (زيارة الخليج 2025)
الدولة إجمالي الالتزام المالي القطاعات/الصفقات الرئيسية
السعودية 600 مليار دولار الطاقة، الدفاع (142 مليار دولار صفقات أسلحة)، التكنولوجيا (ذكاء اصطناعي، مراكز بيانات)، المعادن، البنية التحتية
الإمارات العربية المتحدة 200 مليار دولار (صفقات قصيرة الأجل)1.4 تريليون دولار (تعهد لعشر سنوات) الذكاء الاصطناعي، الطيران، الطاقة، القطاعات الصناعيةتشمل أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي (G42)، صفقة الاتحاد-بوينغ بقيمة 14.5 مليار دولاراستثمار طويل الأمد في الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، مراكز بيانات، أشباه الموصلات
قطر تحقيق تبادل اقتصادي لا يقل عن 1.2 تريليون دولار
243.5 مليار دولار صفقات اقتصادية الطيران (96 مليار دولار لطائرات بوينغ) أكبر طلبية لطائرات بوينغ في التاريخالدفاع (مليار دولار أنظمة مضادة للطائرات المسيرة، مليارا دولار طائرات مسيرة، 38 مليار دولار صفقات دفاعية محتملة) منها 10 مليارات دولار لقاعدة العديد
زيارة ترامب إلى الخليج 2025 لم تكن مجرد جولة بروتوكولية، بل هي نقطة تحوّل إقليمية ودولية في العلاقات الأميركية الشرق الأوسطية في عهد ترامب. أعادت هذه الزيارة تعريف دور الخليج في المعادلة الدولية كحليف استراتيجي وأساسي للولايات المتحدة الأميركية. وعلى رغم أنّ ذلك لا يحدّ من متانة العلاقة الأميركية – الإسرائيلية، إلّا أنّه مؤشر إلى تراجع نسبي لدور إسرائيل التقليدي ويضع المصالح الاقتصادية في صدارة السياسة الأميركية. ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه التحولات في تحقيق استقرار حقيقي للمنطقة أم أنها ستفتح الباب أمام تنافسات جديدة أكثر تعقيداً؟
– صحافية لبنانية
درج
——————————————-
نائبان أميركيان ينقلان موقف الشرع من اتفاقات إبراهام لترامب
حدد شروطه للوصول إلى “اتفاق ما” مع إسرائيل
إيلاف من دمشق: ذكر عضوان في الكونغرس الأمريكي أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب خلال لقاء جمعهم الشهر الماضي، عن انفتاحه سرا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام والتوصل لاتفاق ما مع إسرائيل.
وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”، طلب الشرع ضمانات بأن تتوقف إسرائيل عن قصف سوريا، ووقف تغذية الانقسامات الطائفية، والوصول إلى ترتيب التفاوض بشأن هضبة الجولان، كما أفاد النائبان كوري ميلز (جمهوري عن فلوريدا) ومارتن ستوتزمان (جمهوري عن إنديانا).
ونقل ميلز عن الشرع قوله: “نحن منفتحون على الحوار، وقد نوقشت معنا مسألة الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام والتطبيع مع إسرائيل، لكن يجب أن يتوقفوا عن القصف داخل بلدنا”.
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة الأسبوع الماضي خلال جولته في الشرق الأوسط عندما قال بعد لقائه بالزعيم السوري بأن “الشرع الشاب الوسيم” سينضم إلى اتفاقيات إبراهام، وهو إنجاز رئيسي في السياسة الخارجية لفترته الرئاسية الأولى الذي شهد تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل.
وقبل هذه التصريحات، نقل الشرع انفتاحه لاتفاقيات إبراهيم لكل من ميلز وستوتزمان خلال اجتماعات منفصلة معهما، وكانا أول عضوين في الكونغرس يزوران الزعيم السوري الجديد منذ انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وزعم ستوتزمان أن الشرع أخبره أنه “سيكون منفتحا لاتفاقيات إبراهام” بشرطين رئيسيين. وأوضح: “الأول كان أن إسرائيل لديها خطة لتقسيم البلاد إلى أجزاء منفصلة. لا أعرف إذا كان هذا صحيحا أم لا، لكن هذا ما أخبرني به، وقال إن ذلك سيكون عائقا أمام أي اتفاق. يريد الحفاظ على سوريا موحدة.. أي جهد لتقسيم البلاد إلى أجزاء إقليمية أو طائفية غير مقبول، والثاني كان هضبة الجولان، والتعدي حول هضبة الجولان – وأنه سيتعين عليهم التفاوض مع إسرائيل أكثر حول ذلك”.
ووفقا لستوتزمان، لم يحدد الزعيم السوري ما إذا كان الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام مشروطا باستعادة الجولان، لكنه اشترط ببساطة “الوصول إلى اتفاق ما”.
وأشارت صحيفة “نيويورك بوست” إلى أنه بينما توجد عقبات كبيرة في الطريق، فإن انضمام سوريا افتراضيا إلى اتفاقيات إبراهام سيشكل اختراقا هائلا في السياسة الخارجية في المنطقة.
وقال ميلز: “هذا مهم للغاية، أنت تتحدث عن إمكانية تحقيق استقرار مستمر في المنطقة ومزيد من الاعتراف بحماية إسرائيل العظمى”.
إضافة إلى ذلك، يأتي انفتاح الشرع المزعوم على صفقة مع إسرائيل بينما يحاول على ما يبدو إصلاح العلاقات المتوترة لسوريا مع الغرب والدول العربية في المنطقة.
وقال ستوتزمان: “طوال حياتي، كانت سوريا تحت حكم نظام الأسد. ذكر الشرع أنه طرد بالفعل حزب الله والإيرانيين من سوريا، ويتحدث مع القطريين والسعوديين والإماراتيين لتعزيز التجارة، سيكون بطلا إقليميا إذا تمكن من تحقيق الرؤية التي يملكها لسوريا”.
ايلاف
————————————
سوريا بعد رفع العقوبات/ عمرو الشوبكي
22 مايو ,2025
ستدخل سوريا مرحلة جديدة بعد قرار الرئيس الأمريكى فى الرياض رفع العقوبات عنها؛ لأنه أعقبه قرار أوروبى آخر برفع العقوبات، وأصبحت دمشق أمام مرحلة جديدة لم تعد فيها عقوبات أو تصنيفات المجتمع الدولى عائقًا أمام المسار الجديد، إنما بات أداء النظام وقدرته على مواجهة مشاكله الداخلية هو العامل الحاسم أمام نجاحه أو تعثره.
إن رفع العقوبات عن سوريا ليس مجرد قرار إجرائى اتخذه رئيس أكبر دولة فى العالم، إنما هو بوابة لاندماج سوريا داخل المنظومة العالمية، بحيث سيسمح لها بالتصدير والاستيراد دون أى قيود، وستكون على بداية الطريق لحل مشكلات المشافى البدائية والمصانع المتهالكة، وستفتح الباب دون أى قيود أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يعنى ولو من الناحية النظرية دوران عجلة الإنتاج وانطلاقها إذا وجدت بيئة داخلية سياسية واقتصادية تكون قادرة على إخراج طاقة المواطن السورى فى البناء والإنتاج، وهى الطاقة التى شهدها العالم مع سوريى المهجر، وكانت دليلًا على جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز.
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات عديدة تواجه النظام الجديد، فهناك الأزمة الاقتصادية التى كانت المقاطعة أحد أسباب تفاقمها، وهناك مشكلة التوافق السياسى بين النظام الجديد والمكونات الأخرى، خاصة الدروز والعلويين.. وأخيرًا، هناك أزمة بناء المؤسسات الجديدة التى مازالت لم تنل قبولًا شعبيًا ومناطقيًا شاملًا، ومازالت بعض الأطراف تنظر إليها على أنها امتداد للفصائل المسلحة وليس مؤسسات وطنية محايدة.
صحيح أن قادة سوريا الجدد يبنون مؤسسات جديدة من خارج نظام المحاصصة واقتسام السلطة الذى فشل فى كل التجارب العربية الأخرى، كما جرى فى السودان أثناء حكومة حمدوك أو يجرى فى ليبيا من انقسام بين الشرق والغرب وانقسام آخر داخل طرابلس الغرب تحول إلى اشتباكات على مدار أسبوع كامل، ومع ذلك فإن هذا المسار السورى لا يخلو من أخطار، أهمها: كيف يمكن بناء مؤسسات دولة مهنية ومستقلة عن السلطة التنفيذية يحكمها تقريبًا لون عقائدى وسياسى واحد، وخلفيات كثير من عناصرها قادمة من فصائل إسلامية متشددة وبعضها ارتكب بعد الوصول للسلطة انتهاكات فجة؟.
لقد نجح النظام الجديد فى مهمته الأولى التى تتمثل فى إسقاط بشار، وضمن من أجل تحقيق هذا الهدف حاضنة شعبية من الأغلبية السنية وقطاعات واسعة من الطوائف الأخرى، ولكنه بالقطع لن يحصل على نفس الحاضنة فيما يتعلق بتقييم أدائه فى حكم البلاد.
لقد تقدمت سوريا خطوة نحو الاستقرار وغيرت الولايات المتحدة تصنيفاتها لقادة سوريا التى سبق أن اعتبرتهم «إرهابيين»، والآن اعتبرتهم قادة تحرر وزعماء جديرين بالثقة، وأصبح أداؤهم وقدراتهم على بناء مؤسسات جديدة تحصل على شرعية مجتمعية وتمتلك أداء مهنيًا احترافيًا، ولو بالمعنى النسبى، هو التحدى الكبير أمام بناء سوريا الجديدة.
* نقلا عن “المصري اليوم”
——————————-
ترامب والشرق الأوسط.. ما بين عودة أميركية متأخرة وارتدادات “طوفان الأقصى”/ صهيب جوهر
2025.05.22
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جولته الخليجية محاطاً بشعور بالرضى، نابعٍ من حجم الاستقبال السخي الذي حظي به من قبل دول الخليج، ليس فقط من الناحية الاستثمارية، بل أيضاً لاقتناعه المتزايد بأنّ الشراكة مع الحلفاء الخليجيين تمثل للولايات المتحدة ركيزة استراتيجية قد تتجاوز حتى أهمية العلاقة مع إسرائيل.
هذا الإدراك تعزز في واشنطن بعد أن شعرت المملكة العربية السعودية، خلال ولاية الرئيس جو بايدن، بتراجع الالتزام الأميركي تجاه الخليج، خصوصاً في ظل انشغال الإدارة بالملف الإيراني. هذا التراجع دفع الرياض إلى المبادرة نحو طهران، حيث أبرمت اتفاقاً برعاية صينية لحماية مصالحها، في رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أنها لم تعد تحتمل تجاهلها. أثار هذا التحرك امتعاضاً لدى الأميركيين، ما دفعهم إلى إعادة تقييم مقاربتهم تجاه المنطقة.
في الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2023، غاصت إدارة بايدن في تداعيات الحرب الأوكرانية، ما وفّر فرصة لكل من إيران والصين لتعزيز نفوذهما في الشرق الأوسط. الإيرانيون استغلوا الغياب الأميركي لرفع سقف مطالبهم فيما يتعلق بالملف النووي والنفوذ الإقليمي، بينما فتحت الصين قنوات اختراق ناعمة في المنطقة.
أمام هذا الواقع، سعت واشنطن إلى ترميم علاقاتها مع أبرز حليفين لها في المنطقة: إسرائيل والسعودية. الهدف كان واضحاً: الدفع باتجاه تسويات كبرى تؤسس لتوازن جديد في الشرق الأوسط يحفظ مصالحها الحيوية. وفي هذا الإطار، طرحت السعودية شرطاً أساسياً للمضي قدماً في أي مسار سلام مع إسرائيل، وهو التمسك بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002، والتي تنص على مبدأ “الأرض مقابل السلام” وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ورغم إبداء إسرائيل استعداداً شكلياً لمناقشة هذه المبادرة، فإنها اشترطت “تحديثها” لتتوافق مع التحولات الإقليمية والدولية التي حصلت خلال العقدين الماضيين. وانطلقت بالفعل ورشة داخل الجامعة العربية لبحث صيغة مطورة للمبادرة يمكن طرحها مجدداً كمرجعية للمفاوضات مع إسرائيل، ما أعطى انطباعاً بوجود تحرك عربي متكامل نحو تسوية سياسية.
لكن هذا المسار تلقى ضربة قاسية في السابع من أكتوبر 2023، مع تنفيذ حماس لعملية “طوفان الأقصى”، التي سرعان ما أشعلت حرباً اقليمية المنطقة. وأدى هذا التطور إلى تجميد كل المساعي السياسية. يرى بعض المحللين أن العملية هدفت، من وجهة نظر “حماس”، إلى إحباط مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، الذي كان على وشك تحقيق اختراق في الملف الفلسطيني. وخاصة أن إيران سعت من خلالها إلى منع الرياض من الحصول على دعم نووي أميركي، وعرقلة التقارب السعودي الإسرائيلي، وإجبار الأطراف كافة على الاعتراف بموقع طهران في أي تسوية إقليمية مقبلة.
وهذا التصور خرج للعلن مع التحقيق الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال والذي كشفت من خلاله عن وثائق عُثر عليها في أنفاق في غزة. ووفقاً لهذه الوثائق، فإن قائد الحركة في غزة يحيى السنوار خطط للعملية منذ عامين، واختار توقيت تنفيذها بهدف قطع الطريق على التسوية السياسية الجارية آنذاك بين الرياض وتل أبيب.
كما ذكر التحقيق أن التنسيق بين “حماس”، و”حزب الله”، وطهران، بدأ منذ صيف 2021، وشمل دعماً لوجستياً وعسكرياً وتدريباً قبيل العملية. غير أن الإيرانيين والحزب أكدا للحركة أنهما لا يرغبان في التورط بحرب مفتوحة ضد إسرائيل.
وتفيد إحدى الوثائق السرية التي أعدتها “حماس” في آب 2022، بأن الحركة قررت إعادة تموضعها السياسي والعسكري بهدف إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام، في مواجهة موجة التطبيع العربي. وهذا يتطلب، بحسب الوثيقة، تعزيز التنسيق مع “حزب الله” وفصائل فلسطينية أخرى.
في ضوء ذلك، تتبلور اليوم معطيات جديدة تُسهم في تفكيك خلفيات المشهد السياسي والعسكري المتفجر، ويمكن استخلاص أبرز الحقائق التالية:
أولاً: كانت هناك فعلياً ملامح تقدم في مسار التسوية السلمية، بمشاركة سعودية قائمة على مبادرة بيروت، لكن الالتزام الإسرائيلي الجاد لم يكن مؤكداً.
ثانياً: جاءت عملية “طوفان الأقصى” بهدف مباشر لإجهاض هذا المسار ومنع أي اختراق سياسي لا يلحظ مستقبل الدولة الفلسطينية.
ثالثاً: وقفت إيران خلف هذا الخيار، سعياً لوقف التطبيع السعودي الإسرائيلي ومنع حصول الرياض على تكنولوجيا نووية، مع الحفاظ على حضورها في المعادلات الإقليمية.
رابعاً: رغم الخلافات بين ترامب وبايدن، فقد أدرك كلاهما أن الدور السعودي لا غنى عنه في أي تسوية، وأن القرار النهائي في يد دول الخليج.
خامساً: حرص حزب الله، بدفع من إيران، على ضبط مشاركته في الحرب ضمن حدود الدعم الميداني، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
وقبل أي تطورات مرتقبة، لا بد من ترقب الجولة الجديدة للموفدة الأميركية، التي يُمهد لها بتصريحات مرتفعة النبرة. وفي حين يتمسك حزب الله بسلاحه بغض النظر عن الضغوط والظروف، مستعداً لتحمل تبعات هذا الخيار مهما تصاعدت، تشير المعطيات الواردة من واشنطن، إلى وجود تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المؤكد أن هذا التقدم لا يقتصر على الملف النووي وحده، رغم إصرار الوفد الإيراني على حصر النقاش في هذا الإطار إعلامياً، بل يشمل ملفات إقليمية متعددة. وربما تكون بيروت دمشق يترقبان بصيص الأمل الآتي من مسقط.
تلفزيون سوريا
——————————————-
رفع العقوبات عن سوريا بعيون لبنانية/ محمد فواز
2025.05.22
بالرغم من توجه سوريا التدريجي نحو استعادة انفتاحها الدولي، جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفع العقوبات المفروضة عليها مفاجئاً ومتسارعاً، خصوصاً من حيث التوقيت.
دفع هذا القرار القوى والدول الإقليمية إلى إعادة تقييم تداعياته، وكان لبنان، نظراً لارتباطه الجغرافي والتاريخي والاقتصادي والاجتماعي الوثيق بسوريا، من بين أكثر الدول التي يُتوقع أن تتأثر بهذا التطور. لذلك انكبّ الباحثون والمحللون على دراسة انعكاسات القرار المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإنسانية في لبنان.
فرص رفع العقوبات عن سوريا بالنسبة للبنان
لبنان، المحاط جغرافياً وتاريخياً بسوريا، يأمل في تعظيم فوائد رفع العقوبات، بدءاً من إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين دون عوائق خارجية. فقد يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة تدفق السلع والمنتجات عبر الحدود، مما ينعش الاقتصاد اللبناني وينشط الشركات المحلية ويوفر فرص عمل أوسع. وبما أن سوريا تمثل المنفذ البري الوحيد للبنان إلى المنطقة العربية الأوسع، بما في ذلك الأردن والعراق ودول الخليج، فقد توقفت هذه الروابط إلى حد كبير منذ عام 2011.
لذا، يُنظر إلى رفع العقوبات كفرصة لإحياء هذه الطرق الحيوية، ما يعزز صادرات لبنان ويخفف تكاليف وارداته ويخفف من التحديات اللوجستية التي تواجهها.
من جهة أخرى، يمكن للبنان أن يستفيد من المشاركة في عملية إعادة الإعمار السورية، إذ بإمكان الشركات اللبنانية ورأس المال البشري اللبناني أن يلعبا دوراً مباشراً في هذا القطاع المتوقع النمو. كما قد يتحول لبنان إلى نقطة عبور رئيسية وقاعدة لوجستية للشركات الدولية المشاركة في جهود الإعمار.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ قد يكون رفع العقوبات بوابة لإحياء مشاريع الطاقة الإقليمية التي توقفت بسبب قانون قيصر الأميركي، مثل استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا. ويرى المسؤولون أن هذا المشروع، الذي قد يخفف من أزمة الكهرباء اللبنانية، يمكن أن يُستأنف بنجاح، فضلاً عن إمكانية إعادة تفعيل مصفاة طرابلس، مما يعزز دوره في الربط التجاري والنفطي العربي مع أوروبا.
علاوة على ذلك، قد يسهم رفع العقوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة ككل، ما ينعكس إيجاباً على لبنان عبر تعزيز العلاقات التجارية. كما قد ينعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا إيجابياً على قطاع السياحة اللبناني، مع احتمال عودة السياح السوريين في حال تحقق الاستقرار والانتعاش.
إضافة، فإن سقوط النظام السوري ورفع العقوبات قد يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين السلطات اللبنانية والسورية حول إدارة الحدود المشتركة وعودة اللاجئين.
على المقلب الآخر، فإن أي انتعاشة في سوريا تنعكس مباشرة على المشهد السياسي اللبناني، حيث تثير مخاوف حزب الله والتيارات التي تدور في فلكه، في حين تبث بارقة أمل في صفوف التيارات المعارضة، لا سيما السنية التي ترى في سوريا الجديدة امتداداً طبيعياً لها ودعماً لحضورها الداخلي، كما كان الحال معاكساً في عهد الأسد.
اللاجئون في لبنان
أما الملف الأكثر حساسية فهو ملف اللاجئين السوريين في لبنان، الذي شكل محور نزاعات سياسية حادة على مدى سنوات. إن رفع العقوبات عن سوريا عزز توجهات لدى بعض التيارات، خاصة اليمينية منها، التي تعتبر أن رفع العقوبات يعزز من تراجع مبررات استمرار وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في لبنان. هذا الموقف دفع عدداً من القادة السياسيين اللبنانيين إلى الدعوة لإعادة النظر العاجلة في سياسات اللجوء فيه والتنسيق مع الأمم المتحدة لوضع خطة منظمة لعودة اللاجئين إلى سوريا.
مع ذلك، لا يزال وضع اللاجئين في لبنان معقداً وغير مستقر. فاللاجئون يعبرون غالباً عن أملهم في العودة إلى ديارهم، لكنهم في الوقت نفسه يُظهرون تردداً واضحاً نظراً لحالة عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع السورية على المدى القريب والبعيد. تشمل هذه المخاوف أسس الحياة الأساسية مثل الحصول على التعليم، وفرص العمل، وقضايا السكن، وملكية الأراضي، بالإضافة إلى قدرة الدولة والمجتمع على توفير المساعدات الإنسانية.
لذلك، فإن التغيير السياسي في سوريا لا يمحو الصدمات العميقة التي عانى منها اللاجئون، ولا يزيل ترددهم المستمر، خصوصاً وأن إعادة بناء سوريا واستعادة استقرارها تحتاج إلى وقت طويل قبل أن يشعر اللاجئون بالأمان الكافي للعودة.
تحديات رفع العقوبات
لكن بالمقابل لا يخلو رفع العقوبات من تحديات للبنان في حال لم تعرف القيادة السياسية فيه كيفية إدارة الملف لينتقل حينئذ التعاون واستجلاب الفرص إلى منافسة ومجابهة.
إن أول هذه التحديات تتمثل في المنافسة الاقتصادية المحتملة، حيث قد يؤثر تعافي الاقتصاد السوري على الميزات التنافسية التي يتمتع بها لبنان جغرافيًا واقتصاديًا وتجاريًا. علاوة على ذلك، قد يؤدي انتعاش الاقتصاد السوري إلى أزمة في سوق العمل اللبناني، حيث من الممكن أن يعود عدد كبير من العمال السوريين إلى وطنهم مع تحسن الظروف هناك. وهذا يشكل تحديًا لبيروت في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار وتنمية بنيتها التحتية، خاصة أن العمال السوريين يشكلون جزءًا هامًا من القوى العاملة في قطاعات مثل الزراعة والإعمار.
كما تظل قدرة لبنان على استغلال الفرص مرتبطة بشكل وثيق بسرعة تنفيذ سوريا لإصلاحاتها الداخلية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. فالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لن تبدأ في الظهور إلا بعد أن تتمكن سوريا من تخفيف العقوبات بشكل فعلي واستعادة سيطرة الدولة على كامل أراضيها. تحد آخر داخل الشارع اللبناني وهو سحب فتيل أي إمكانية لتحويل النهوض السوري المحتمل إلى حالة استقطاب لبناني داخلي.
على المستوى الدولي، لا تزال العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا قائمة، مما يجعل العديد من البنوك والشركات العالمية مترددة في العودة إلى السوق السورية، وهو ما يحد من قدرة لبنان على الانفتاح الكامل على الاقتصاد السوري.
وأخيرًا، تعكس العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا تاريخًا معقدًا، لا تزال تعاني من نقص في التعاون الاستخباراتي والحدودي. وتبقى ملفات اللاجئين والرقابة على الحدود مصدرًا للنزاعات والخلافات، مما يزيد من صعوبة تنسيق الجهود والاستفادة المثلى من التغيرات السياسية والاقتصادية الجارية في المنطقة.
في المجمل، يتطلب رفع العقوبات عن سوريا من لبنان استعدادًا شاملاً واستراتيجيات لبنانية واضحة عمقها التواصل الفعّال مع سوريا الجديدة لتحقيق الفرص وتجنب التحديات.
تلفزيون سوريا
———————————
رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا: إعادة تموضع وبداية شراكة مشروطة/ أحمد العكلة
21 مايو 2025
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في البلاد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أنه تم تعليق العقوبات على قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء) والنقل، مما يسهل إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية في البلاد. كما تم رفع العقوبات عن خمسة بنوك سورية رئيسية، ما يتيح لها الوصول إلى الأصول المجمدة وإجراء المعاملات المالية، وذلك إضافةً إلى تمديد الاستثناءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى، بما يسهل تنفيذ مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار.
اعتبر الخبير الاقتصادي فراس شعبو، في تصريح لـ”الترا سوريا”، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يمثل “نقطة تحول استراتيجية” في مسار الاقتصاد السوري، إذ من شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقًا واسعة في مجالات الاستثمار، وتُعيد الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحسّن صورة سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو أن رفع العقوبات، سواء الأوروبية أو الأمريكية، سيسرّع من إعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، ويُسهّل إعادة تفعيل نظام “السويفت” والتحويلات البنكية، ما يُتيح تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع مجددًا.
أثر العقوبات على التجارة والتمويل
وأشار شعبو إلى أن العقوبات الأوروبية شكلت مع نظيرتها الأمريكية تأثيرًا مزدوجًا على الاقتصاد السوري، انعكس سلبًا على حركة التصدير. وذكر أن سوريا كانت تُصدّر قبل عام 2011 ما يقارب 3.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي، وهو رقم انخفض بشكل كبير خلال سنوات الأزمة.
وأضاف أن مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي كانت تقدّم منحًا سنوية تتراوح بين 200 و250 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء، وهو ما فُقد خلال السنوات الماضية، مما أضر بشكل كبير بالنمو الاقتصادي.
ورغم تفاؤله بقرار رفع العقوبات، حذر شعبو من أن الاقتصاد السوري يعاني مشكلات بنيوية عميقة، تشمل ضعف البنية التحتية وقطاع النقل والطاقة، فضلاً عن تراجع أداء المصرف المركزي وضعف السيولة في القطاع المصرفي، مما يُعيق التعافي المبكر.
كما شدد على ضرورة تسريع عملية إعادة تأهيل البنية التحتية وتفعيل النظام المصرفي، محذرًا من أن أي تأخير في هذه الخطوات سيجعل الاستفادة من رفع العقوبات محدودة، ويُبقي التركيز على قطاعات مثل الزراعة والصحة فقط.
وفيما يخص جذب الاستثمارات، أكد شعبو أن المستثمرين، وخصوصًا من دول الخليج، أبدوا رغبة متزايدة بدخول السوق السورية، مستشهدًا بتصريحات الملياردير الإماراتي خلف الحبتور حول نيته الاستثمار في سوريا. لكنه شدد على أن هذا الانفتاح يتطلب توافر الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب ضمانات قانونية تحمي حقوق المستثمرين وتكفل الملكية الخاصة.
وأضاف: “نحتاج إلى قوانين واضحة، وإلى التخلي عن مفاهيم مثل التأميم وتغليب المصلحة العامة على حقوق الأفراد، وهي مفاهيم كانت تُنفّر المستثمرين سابقًا”.
هل رفع العقوبات كافٍ؟
ورأى شعبو أن رفع العقوبات، رغم أهميته، ليس حلاً سحريًا، بل فرصة يجب استغلالها من خلال إدارة رشيدة تعتمد على الشفافية والحوكمة وكفاءة في إدارة موارد الدولة. وأوضح أن الهيكلية الحالية للاقتصاد السوري تحتاج إلى تحديث عميق وإصلاحات حقيقية.
وفيما يتعلق بالقطاعات المتوقع أن تنتعش، حدد شعبو الطاقة والصحة والزراعة والطاقة المتجددة، كأبرز المجالات التي ستجذب الاستثمارات. أما عن تأثير رفع العقوبات على سعر صرف الليرة السورية، فرأى أن التأثير الحالي نفسي أكثر منه اقتصادي أو نقدي، موضحًا أن أي تحسّن في سعر الصرف سيكون لحظيًا ما لم يصاحبه تحسّن فعلي في المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن الأسعار في السوق لا تعكس سعر الصرف الرسمي، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، ما يُسبب خللًا واضحًا في السياسة النقدية.
واختتم شعبو حديثه بالتأكيد على أهمية تأسيس هيئة مستقلة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لمنع تكرار تجارب الفساد أو الهيمنة التي عانى منها الاقتصاد السوري في الماضي. وقال: “نحن لا نريد خلق شبكات تستفيد من الاقتصاد وحدها، بل نريد اقتصادًا يخضع لحوكمة شاملة تُحقق العدالة والاستفادة الجماعية”.
وختم قائلًا: “رفع العقوبات ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لفرصة حقيقية، يجب أن تُدار برؤى اقتصادية وتشريعات حديثة، بما يُسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن السوري خلال الفترة المقبلة”.
يؤكد الكاتب والباحث السوري، د. باسل معراوي، في حديثه لموقع “الترا سوريا”، أن سوريا تمثل جوارًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للقارة الأوروبية، نظرًا لقربها الجغرافي وتشاطئها مع دول القارة على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعل من عدم استقرارها مصدر تهديد مباشر للأمن الأوروبي.
ويشير معراوي إلى أن أوروبا، التي رسمت خريطة المنطقة السياسية عبر اتفاقية سايكس-بيكو، فقدت نفوذها فيها بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فانشغلت ببناء نهضتها الاقتصادية وتخلت عن أدوارها الجيوسياسية، لتتحول لاحقًا إلى “ملحق في المجرة الأمريكية”.
ومع اشتعال الصراع الدولي على الأراضي السورية، تنبّه الأوروبيون إلى غيابهم عن ساحة يتصارع فيها الإيرانيون والروس والأتراك والأمريكان والإسرائيليون، فيما تدفع أوروبا ثمن هذا الصراع من خلال موجات اللجوء، وانتشار الكبتاغون، وتسلل الإرهاب إلى عمق القارة.
يتعمق الاهتمام الأوروبي بسوريا، وفق معراوي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعدت حدته مع سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قلل من أهمية التزام واشنطن بحلف الناتو. هذا الواقع دفع الأوروبيين إلى التفكير بجدية في حماية أنفسهم ذاتيًا، والبحث عن تحالفات قريبة جغرافيًا،حيث تُعد سوريا أبرز الخيارات المتاحة.
ويوضح معراوي أن أوروبا تخلّت كليًا عن الطاقة الروسية بعد تفجير أنابيب “نورد ستريم 2″، وباتت تبحث عن بدائل في الشرق الأوسط. وهنا تبرز سوريا كممر محتمل للطاقة القادمة من الخليج، وكبلد واعد باكتشافات غازية بحرية، ما يجعل من استقرارها هدفًا أوروبيًا استراتيجيًا لا يمكن تحقيقه دون إنهاء العقوبات وإطلاق نهضة اقتصادية.
رسائل أوروبية للداخل والخارج: دعم الدولة السورية الجديدة
ويشير معراوي إلى أن الرسائل الأوروبية باتت واضحة، بدءًا من الداخل السوري، حيث توجه دعوة صريحة لدعم مسار التغيير السياسي، وحث الأقليات على التحاور والانخراط في مؤسسات الدولة الجديدة دون انتظار “حمايات خارجية”. فالاتحاد الأوروبي، بحسب معراوي، لن يدعم إلا الدولة السورية ومؤسساتها، وليس أطرافًا تتصارع على السلطة.
أما الرسالة الثانية فهي موجهة للخارج، وتؤكد أن أوروبا معنية بدعم سوريا وبناء علاقات مستقلة معها بعيدًا عن المواقف الأمريكية أو غيرها، وهو ما يعكس رغبة في بناء جسور تواصل وعلاقات مستقرة مع دمشق.
وفيما يخص تعقيدات الملف السوري، يرى معراوي أن الخلاف الأوروبي الحقيقي لا يكمن مع الولايات المتحدة أو الدول العربية، بل مع تركيا. فهناك حساسية أوروبية شديدة تجاه طموحات أنقرة الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والمياه الاقتصادية، كما هو الحال مع اليونان وقبرص.
ويشير إلى أن الدول الأوروبية ترفض بشكل قاطع انفراد تركيا بتسليح أو تدريب الجيش السوري الجديد، وتحاول كبح جماح النفوذ التركي المتزايد، وهو ما يفسر إصرار الرئيس الفرنسي على دعوة نظيره السوري لزيارة باريس بهدف كسر الجليد وفتح باب العلاقات.
ويختم معراوي بالتأكيد على أن الملف السوري، وخصوصًا ملف اللاجئين، أصبح قضية داخلية أوروبية. فهو يُستغل سياسيًا من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحملات الانتخابية، ما يجعل من تحقيق الاستقرار في سوريا هدفًا حيويًا يسحب هذه الورقة من يد خصوم الأنظمة الليبرالية.
وترى الحكومات الأوروبية، بحسب معراوي، أن العودة الطوعية لمن لم ينجحوا في الاندماج باتت خيارًا مقبولًا، خاصة في ظل غياب أفق واضح لحل دائم، الأمر الذي يعزز من ضرورة دعم الدولة السورية وتحقيق الاستقرار على أراضيها.
يرتبط استمرار رفع العقوبات الأوروبية بالتزام الحكومة السورية الجديدة بالعملية السياسية وتشكيل حكومة شاملة. الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه.
أكد د. زكريا ملاحفجي، أمين عام الحركة الوطنية السورية، في تصريح خاص لموقع “الترا سوريا”، أن خطوة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن النظام السوري لم تأتِ بشكل جزئي أو تدريجي، بل جرت بشكل كامل ومفاجئ، ما يشير إلى تحوّل واضح في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
وأوضح ملاحفجي أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بناءً على عدة اعتبارات، أبرزها قضية اللاجئين والضغوط المتزايدة من أجل تأمين بيئة مستقرة تسمح بعودتهم. وأضاف أن هناك مصالح استراتيجية أوروبية تتعلق بالممرات الدولية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكذلك بخطوط الطاقة القادمة من الخليج والعراق، والتي تمر عبر سوريا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة الأوروبية لم تكن معزولة، بل جاءت بعد “تجرؤ” الولايات المتحدة واتخاذها إجراءات مماثلة، مما أعطى الأوروبيين هامشًا أكبر للتحرك سياسيًا في هذا الاتجاه.
يمثل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تحولاً مهمًا في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد، لكنه لا يزال مشروطًا بالتغيير والإصلاح السياسي الحقيقي. المرحلة المقبلة ستحدد مدى نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
الترا سوريا
————————————–
ين التفاؤل الحذر والشك.. تغطية الصحافة الأميركية للقاء ترامب والشرع
21 مايو 2025
قدّمت الصحافة الأميركية طيفًا من الآراء المتباينة بشأن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع، الذي جرى منتصف أيار/مايو الجاري في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إعلان ترامب عن قراره رفع العقوبات عن سوريا.
ومزجت آراء الصحافة بين التفاؤل الحذر والشك، وركّزت تغطية وسائل إعلام رئيسية مثل PBS وNPR و”نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” وCNN على هذا التحول الدبلوماسي وتداعياته، مشيرةً في كثير من الأحيان إلى تعقيد القرار نظرًا للاضطرابات السياسية الأخيرة في سوريا وخلفية الشرع المثيرة للجدل كزعيم جهادي سابق.
تفاؤل داعم لكن حذر
سلطت شبكة PBS وصحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على إمكانية تخفيف العقوبات لمساعدة سوريا على التعافي بعد الأسد، حيث أشارت PBS إلى اجتماع ترامب مع الشرع كخطوة نحو التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” إشادة الشرع بقرار ترامب “الشجاع والتاريخي”، مما يشير إلى استقبال إيجابي في بعض الأوساط.
كما اتخذت منظمة “السياسة المسؤولة” موقفًا داعمًا بشكل ملحوظ، واصفةً خطوة ترامب بأنها “إعادة ضبط حكيمة وجريئة لسوريا”، مجادلةً بأن رفع العقوبات “القاسية والمُشلّة” يمكن أن يسمح للسوريين “بالتألق” بعد سنوات من الحرب.
وفي السياق أشاد محللون يكتبون في “ريسبونسبل ستيت كرافت”، وبينهم معلقون مُخضرمون في السياسة الخارجية، بقرار ترامب باعتباره اعترافًا عمليًا بالواقع الجديد في سوريا بعد الأسد. وجادلوا بأن العقوبات أضرت بالمدنيين بشكل غير متناسب، وأن رفعها يمكن أن يعزز الاستقرار، بما يتماشى مع استراتيجية ترامب الأوسع في الشرق الأوسط.
ووصف المساهمون في صحيفة “وول ستريت جورنال”، المعروفة بمجلس تحريرها ذي الخبرة في هذا المجال، الاجتماع بأنه خطوة دبلوماسية جريئة، حيث أشار رد الشرع الإيجابي إلى إمكانية المشاركة البناءة بين الولايات المتحدة وسوريا، غير أن كتاب الصحيفة حثوا، مع ذلك، على “مراقبة دقيقة لحكم الشرع”.
شكوك وقلق
وفي مقابل ذلك الترحيب، أكدت شبكة CNN على مخاطر احتضان الشرع، الذي وُصف بأنه “جهادي تحول إلى رئيس”، وأشارت إلى سعي ترامب لتطبيع العلاقات السورية مع إسرائيل وطرد المقاتلين الأجانب، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذه المطالب.
وفي نفس السياق أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” على التأثير المُعيق للعقوبات، لكنها سلطت الضوء على المخاوف بشأن ماضي الشرع مع “هيئة تحرير الشام”، وهي “جماعة كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة”، في إشارة إلى عدم الارتياح للتعامل مع قائد بهذه الخلفية.
وأشارت إذاعة NPR إلى أن رفع العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس، مما يُلقي بظلال من الشك على فورية تعهد ترامب، ويضعه في إطار لفتة رمزية في انتظار اتخاذ إجراء تشريعي.
ومع أن “المجلس الأطلسي” وصف هذه الخطوة بأنها “تحول محوري”، لكنه أشار إلى مخاوف المحللين بشأن الآثار طويلة المدى، لا سيما في ظل المشهد السياسي المعقد في سوريا والحاجة إلى تنسيق دولي مستدام.
وأعربت تغطية CNN، التي يُرجح أنها استقتها من مراسلين مخضرمين مثل فريد زكريا أو كريستيان أمانبور، عن قلقها إزاء ماضي الشرع الجهادي ومخاطر إضفاء الشرعية على قيادته. وتساءلوا عما إذا كانت شروط ترامب – مثل تطبيع العلاقات مع إسرائيل – واقعية بالنظر إلى الديناميكيات الداخلية في سوريا.
وسلّط محللون في صحيفة “نيويورك تايمز”، ومن بينهم كتّاب أعمدة مثل توماس فريدمان، الضوء على “المعضلات الأخلاقية والاستراتيجية المترتبة على التعامل مع زعيم متشدد سابق”، محذرين من أن “رفع العقوبات دون إصلاحات حوكمة واضحة قد يشجع العناصر المتطرفة”.
تحليل عملي
وأفادت “إنيرجي إنتليجنس” بأنه على الرغم من أن تخفيف العقوبات قد يفيد سوريا، إلا أن العملية ستكون بطيئة ولن تُقدم دعمًا اقتصاديًا فوريًا، مما يعكس وجهة نظر عملية لتحديات هذه السياسة.
وفي السياق نفسه، أكدت تقارير الإذاعة الوطنية العامة، التي صاغها صحفيون خبراء مثل ستيف إنسكيب، على العقبة الإجرائية المتمثلة في موافقة الكونجرس، مشيرين إلى أن إعلان ترامب كان طموحًا أكثر منه عمليًا. ودعوا إلى “نقاش دقيق حول إمكانية تطبيق تخفيف العقوبات بمسؤولية”.
وفي العموم اعتبرت الصحافة الأميركية اجتماع ترامب مع الشرع، ورفع العقوبات، تحولًا سياسيًا مهمًا ولكنه مثير للجدل. وعبّر محللون كثيرون عن هذه الانقسامات، حيث أشاد بعضهم بإعادة ضبط الاستراتيجية، بينما حذر آخرون من مخاطر محتملة في غياب ضمانات قوية. وكانت الحاجة إلى موافقة الكونغرس وتعقيد المشهد السياسي السوري من المواضيع المتكررة في جميع التغطيات.
——————————–
الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا قيد التنفيذ ويتطلب تنسيقاً فيدرالياً
2025.05.23
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا يتطلب تنسيقاً بين عدة وكالات فيدرالية، وإن العملية “قد تستغرق بعض الوقت”.
وفي تصريحات للصحفيين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الرئيس ترامب “اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات”، مشيرة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الخارجية والخزانة بدأ العمل على هذا الملف “بشكل مكثف لإنجازه بأقرب وقت ممكن”.
آليات متشابكة تتطلب تنسيقاً فيدرالياً
ورغم صدور القرار من أعلى المستويات، أوضحت بروس أن عملية رفع العقوبات تمر عبر وزارات ووكالات مختلفة. وقالت إن “الرئيس يملك صلاحيات واسعة، لكن التنفيذ يتطلب إصدار تراخيص وقرارات من جهات متعددة، أبرزها وزارة الخزانة”.
وشددت المتحدثة الأميركية على أن إدارة ترامب تدرك أهمية التسريع في هذه الإجراءات، و”تعمل على ذلك”، لافتة إلى أن العملية تسير بشكل أسرع من المعتاد في مثل هذه الحالات.
تحول الموقف الأميركي من سوريا
في 12 أيار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي، من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابةً لطلب مشترك من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من دولة قطر.
وفي اليوم التالي، عقد ترامب اجتماعاً نادراً مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً.
وخلال جلسة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية، ماركو روبيو، إن واشنطن “تسعى لدعم الحكومة السورية لتفادي حرب أهلية وفوضى قد تزعزع استقرار المنطقة بكاملها”.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، أن توجيهات الرئيس ترامب بدأ تنفيذها فعلياً، وأن إصدار التراخيص اللازمة لجذب الاستثمارات إلى سوريا قيد الإجراء، داعياً الحكومة السورية إلى “اتخاذ خطوات جريئة” لمواصلة هذا المسار.
—————————-
الخارجية الأمريكية: نعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سوريا
واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت.
وذكرت متحدثة الخارجية تامي بروس، أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وأن الوقت حان لذلك.
وأضافت في تصريح صحافي، أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيتم بسرعة.
وأوضحت أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد.
ومؤخرا، أعلن ترامب وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
(الأناضول)
—————————-
سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية
دمشق – أ ف ب: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشَمّاع أن يُسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عَزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم.
ويقول الشماع (45 عاماً) في مقابلة “نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية”.
ويتمنى أن “يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم”، الأمر الذي كان مستحيلاً خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج.
ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.
ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه.
واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية.
ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ”جثة هامدة”.
ويقول”ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال تام”، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة.
ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون “موقتاً” وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات.
ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاماً) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل.
ويقول لفرانس برس “مع رفع العقوبات الآن…ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر” على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم.
وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبُنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة.
وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة “التاريخية”.
ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع “بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا”، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم “فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب”.
ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين.
ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس “مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البُنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس”، مُرَجِّحاً أن “تُسرِّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار”.
لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب “استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً” في “عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى”، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة “كرَم شَعّار” للاستشارات.
وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. وحول ذلك يقول فاف “قبل أن تُجدِّد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المُراسَلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً” نظراً لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال.
ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة.
ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال.
ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها.
داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حالياً هو أن تعمل “تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك” المحظورة عن سوريا.
على صعيد آخر أعلنت جولي كوزاك المتحدثة باسم “صندوق النقد الدولي” أن الصندوق أجرى “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب.
وكان آخر تقييم شامل للصندوق لحالة الاقتصاد السوري قد جرى في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
وأكدت المتحدثة “ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية”.
وتابعت “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.
——————————
لبنان أمام خيارات حاسمة وواشنطن بالمباشر: تعلموا من الشرع
الجمعة 2025/05/23
على لبنان أن يحذو حذو الرئيس السوري أحمد الشرع ويتعلم منه. جملة واحدة قالتها الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس كانت كافية للإشارة إلى المسار الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية رسمه للبنان. والأكيد أن ما تقصده أورتاغوس هو سلوك “مسار السلام” أي الاتجاه إلى اتفاق مع إسرائيل لا سيما أنه بنظر الأميركيين فإن ما يريده الرئيس دونالد ترامب هو إرساء السلام في المنطقة وإدخال المزيد من الدول إلى الاتفاقات الإبراهيمية. بعض الرسائل الدولية التي ترد من الولايات المتحدة الأميركية ومن دول أخرى تشير بوضوح إلى أن سوريا قد سلكت طريق تعويم علاقاتها الدولية سريعاً، بينما لبنان لا يزال متعثراً في خطواته.
فتح حصول الإسرائيليين على الأرشيف الخاص بإيلي كوهين الباب أمام تساؤلات كثيرة حول ما يجري بين سوريا وإسرائيل، وإذا كان هناك تقدماً على مستوى التواصل المباشر أو غير المباشر بين البلدين. فالإسرائيليون منذ سنوات طويلة يخوضون مفاوضات جدّية مع نظام بشار الأسد للحصول على أي معلومة تتصل بمكان دفن جثته وقبل سنوات نجحت إسرائيل في استعادة ساعة يد كوهين. لكن اللافت هو السرعة التي حصلت فيها على كل أرشيفه لاسيما أن ذلك حصل على وقع تحولات كبرى تعيشها المنطقة وخصوصاً سوريا التي التقى رئيسها أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية وبرعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفيما كانت السعودية تصرّ على الحصول من الرئيس الأميركي على موقف يتصل بتأييد حل الدولتين، فهي تعمل مع فرنسا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى لإنجاح مؤتمر دولي يعترف بالدولة الفلسطينية، فحل الدولتين بالنسبة إليها هو المدخل الأساسي للوصول إلى أي اتفاق سلام. السلام هذا هو الذي يركز عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويسعى إلى تحقيقه وإدخال المزيد من الدول في الاتفاقات الإبراهيمية.
لدى زيارة ترامب إلى الرياض، كانت السعودية تريد لسوريا وفلسطين ولبنان أن يشاركوا في اللقاءات، لكن أحمد الشرع وحده هو الذي اتجه إلى هناك وعقد اجتماعاً مع ترامب. بينما استثني لبنان وفلسطين. فاستثناء لبنان جاء بسبب ما يعتبره الأميركيون حتى الآن تعثّر في مسار القيام بما هو مطلوب منه على خط حصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات المطلوبة وسلوك طريق السلام. أما فلسطين فلا تزال ظروفها غير ناضجة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وعدم حصول اتفاق فلسطيني فلسطيني على كيفية إدارة القطاع وإعادة انتاج السلطة الفلسطينية.
في هذه المسارات بدا أحمد الشرع هو الأكثر تقدماً وسرعة، وهو قال بشكل واضح أكثر من مرة إن سوريا لا تريد أن تشكل تهديداً على أي من دول الجوار ويقصد بذلك إسرائيل، كما أشار إلى أن سوريا تريد السلام في المنطقة. كذلك، فقد استجابت دمشق لكل الشروط التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أدى إلى رفع العقوبات. ولكن في الموازاة، كان هناك مسار لتفاوض بين سوريا وإسرائيل، عنوانه مفاوضات غير مباشرة حصلت عبر جهات عديدة.
في بداية مسار التفاوض كان الشرع حريصاً ومتمسكاً بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك التي أقرت في العام 1974، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، وأصروا على تجاوز هذه الاتفاقية وبناء منطقة عازلة في الجنوب السوري، إلى جانب تدمير كل مقدرات الجيش السوري. كذلك لا يريد الشرع التنازل عن الجولان الذي تتمسك به إسرائيل. فهو لا يريد أن يسجل على اسمه وفي تاريخه أن الرئيس السنّي الذي حكم سوريا تنازل عن الجولان. وهو ما سيكون بحاجة إلى مسار تفاوضي طويل للوصول إلى اتفاق بشأنه. لكن الخطوات التي أقدمت عليها دمشق دفعت بالمسؤولين الأميركيين إلى الإشادة بها. ما دفع بمورغان أورتاغوس أن تتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بضرورة التعلم من تجربة الشرع.
ما يقوله الأميركيون للبنان هو أنه يتوجب عليه قراءة التحولات الكبيرة والتاريخية على مستوى المنطقة، لا سيما أن ما يجري فيها لم يحصل منذ عقود، وهي المرّة الأولى التي تكون فيها سوريا صاحبة وجهة مؤيدة للغرب بخلاف تاريخها، كما أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في حالة تخلّف عن السير في هذه الوجهة وإلا سيبقى في حالة انعزال وستكون سوريا هي المستفيدة الأكبر وهي التي ستحصل على الامتيازات والاستثمارات، ليبدو ذلك وكأنه ضغط إضافي على لبنان لاستدراجه للالتحاق بركب المنطقة.
المدن
———————————
المبعوث الأميركي الخاص لسوريا بدأ التنسيق مع دمشق.. مصادر تكشف
العربية. نت – جوان سوز
23 مايو ,2025
بعد تأكيد مصدر دبلوماسي تعيين الولايات المتحدة توماس باراك، سفيرها الحالي لدى أنقرة والصديق الشخصي للرئيس دونالد ترامب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، تصاعدت التساؤلات حول الدور الذي سيلعبه في بلد طوى قبل أشهر صفحة حرب دامت 14 عاماً.
وتعليقاً على التعيين، كشفت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة لـ”العربية.نت” أن القرار الرسمي سيصدر بعد أيام، لكنها أشارت إلى أن السفير الأميركي الحالي بدأ بالفعل بالتنسيق مع السلطات الانتقالية السورية قبل البدء بمهامه.
وأوضحت أن باراك يملك خبرة واسعة في التعامل مع الملف السوري، خاصة من جهة تواصله المستمر مع المعارضة السورية خلال تواجدها في تركيا على مدى السنوات الأخيرة، وتواصل رفيع مع الأحزاب المؤيدة للأكراد، وفق المصادر السابقة.
وسيط بين تركيا وقسد
كما أضافت أن السفير الحالي كان يلعب دور الوسيط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة سد تشرين بين قسد وجماعات مسلحة مدعومة من تركيا.
من جانبه، قال المحلل السياسي والصحافي التركي المعروف أرغون باباهان، إن “قرار تعيين باراك يؤكد أن الولايات المتحدة لا تريد أي هجوم تركي ضد وحدات حماية الشعب”.
كما أضاف لـ”العربية.نت” أن “التصريح الأخير لوزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يستند جزئياً إلى هذه التنبؤات حين تحدث عن حرب أهلية قد تندلع في سوريا”. وتابع أن “أهم طريقة لمنع هذا الصدام يكون ببناء علاقة ثقة مع أنقرة”.
“علاقات أفضل”
إلى ذلك رأى أن “وجود صديق مقرب وداعم لترامب كمبعوث أميركي إلى كل من أنقرة وسوريا سيضمن علاقات أفضل بين الدول الثلاث”.
وأشار باباهان إلى أن “ترامب لا يريد أن تصبح سوريا مشكلة جديدة أمامه”. وقال “أعتقد أن السفير الأميركي سيتصرف كمراقب لواشنطن”.
وكان وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، قال في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها. ودعا إلى دعم دمشق، قائلاً: “إذا نظرتم إلى تاريخ المنطقة، عندما تكون سوريا غير مستقرة، تصبح المنطقة غير مستقرة”.
فيما تزامن تحذيره مع إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
———————————-
==========================
العدالة الانتقالية في سوريا تحديث 23 أيار 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
——————————–
مقال في العدالة الانتقالية في سوريا/ مصطفى حايد -خمسة أجزاء–
تحديات في تنفيذ عدالة انتقالية في سوريا (1/2)/ مصطفى حايد
الالتفات إلى الوراء (2)
20-03-2025
الجزء الأول
ملاحظة الكاتب: تم استخدام النجمة الجندرية للإشارة إلى التنوع الجندري والجنساني الذي تشملها التعابير المستخدمة في هذا المقال
*****
استعرَض المقال الأول من هذه السلسلة بعض فُرصِ العدالة الانتقالية في سوريا بعد أن عرّفها وبيّن وطبيعتها الهجينة، واستعرض أيضاً التحديات التي قد تواجهنا خلال عملية تخطيطها وتنفيذها. ومنه سيركز هذا المقال على بعض هذه التحديات، مستعرضاً تجارب دولية ذات صلة، من شأنها أن ترشدنا خلال هذه العملية.
كُتِب هذا المقال بعد زيارة ميدانية في شباط (فبراير) 2025 إلى سوريا، تجاوزت العشرة أيام، وشملت كل من حلب وإدلب وحمص والسلمية ودمشق وريفها، وجرى خلال هذه الزيارة التحدث إلى أفراد ومجموعات شبابية مختلفة حول أفكارهم* ورؤيتهم* للعدالة والمحاسبة في سوريا، حيث تم تضمين بعض تلك الأفكار في هذا المقال، الذي يأتي على جزأين.
بعض التحديات والعقبات الرئيسية في طريق العدالة
تواجه عملية العدالة الانتقالية تحديات معقدة، خاصة لكونها ليست عملية بسيطة أو مباشرة، وليست فورية أو قصيرة الأمد كما تبيّن في المقال الأول، ولا يمكن احتكارها أو الوصاية عليها من قبل الدولة فقط، أو من فئة واحدة ومحددة في المجتمع، إنما هي عملية متكاملة وشاملة وشفافة. وتتوزع هذه التحديات على ثلاث مستويات أساسية: صعوبات متعلّقة بتخطيط وتنفيذ العملية نفسها والجهة المنفذة لها، وتلك المتعلّقة بالملفات التي ستعمل على معالجتها، وصعوبات تتعلّق بالجهات المستهدفة سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات أو المجتمعات.
وسأنطلقُ من قصة سمعتها خلال زيارتي إلى سوريا من شاب في حمص، لندعوه «رامي»، قبل البدء بالخوض في شرح كل مستوى من هذه المستويات الثلاث.
يعيش رامي في حي من أحياء حمص المأهول بسكّان من خلفيات دينية متنوعة. كان في الثالثة عشر من عمره عندما سمع طرْقاً عنيفاً على الباب وهو وحيدٌ في المنزل، فتح الباب لجد جاره «الشبيح» بعضلاته الضخمة يجرُّ ويركل رجلاً ملطخاً بالدماء. رمى الجارُ الرجلَ داخل المنزل قائلاً: «استلم… هاد من جماعتكون». أخبرني رامي أن تلك الحادثة أثّرت فيه نفسياً إلى درجة كبيرة، وبقي لسنوات طويلة يعاني من الخوف الشديد والهلع. حين جاء «الأمن العام» إلى حي رامي في كانون الثاني (يناير) 2025 وسأله إن كان هناك شبيحة يعرفهم في منطقته، تردد قليلاً ثم أجاب بالنفي. كان رامي عاطفياً جداً إثناء إخباري بالقصة، ولا يعرف إلى الآن إن كان ما فعله هو الصواب أم لا، وختم حديثه بعبارة «بدي جاري الشبيح يتحاسب لأني لهلأ خايف من الموقف اللي صار معي وأنا بالـ13، بس كمان أنا ماني واثق من هدول (الأمن العام) اذا كانوا رح ياخدولي حقي أو لا»، وأضاف: «بدنا عدالة انتقالية مو عدالة انتقائية ولا انتقامية».
تقدم هذه القصة، برأيي، مثالاً تتقاطع فيه صعوبات المستويات الثلاثة المذكورة أعلاه، وتشكل مدخلاً قيّماً للبدء في الحديث عنها.
1- صعوبات متعلّقة بتخطيط وتنفيذ العملية نفسها والجهة المنفذة لها:
ذكرنا أن عملية العدالة الانتقالية لا يمكن احتكارها أو الوصاية عليها من قبل جهة واحدة فقط، حتى وإن كانت الدولة أو الحكومة نفسها، فما بالك إن كانت «الحكومة الجديدة» طرفاً في النزاع، وقد يكون أعضاؤها ومسؤوليها جناة محتملين* و/أو ضحايا محتملين*. لكن الدولة، رغم ذلك، يجب أن تكون الجهة المنفذة لهذه العملية، باعتبار أن المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية جزءٌ منها، ومن هذا الاعتبار أيضاً، يمكننا أن نفهم لماذا يعتبر إشراك الضحايا وعائلاتهم*، والمجتمع بكل مكوناته، والمجتمع المدني أيضاً، أمراً بالغ الأهمية، إذ يضمن نزاهة وعدالة وشمولية هذه العملية.
في المرحلة الانتقالية تكون الحكومات الانتقالية ضعيفة، مهما بدت قوية، فهي تحتاج إلى كسب الشرعية والنفوذ واستعادة السلطات وتوفير الخدمات، وكذلك بناء الثقة. وفي بعض الأحيان، كما هو الحال في سوريا، تكون هناك أعباء أمنية إضافية، خاصةً بعد أن حُلَّ الجيش والمؤسسات الأمنية والحزبية. نحن نتحدث هنا عن عشرات الآلاف من الأفراد ذوي الخبرات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج سلطات تعودوا عليها وأساءوا استخدامها لسنوات، إضافة إلى وفرة وعشوائية في انتشار السلاح في البلاد، مما يهدد بدورات جديدة من العنف والعنف المضاد من جانب، وبإعادة إنتاج الثنائية الكريهة المعتادة؛ «الأمن والإفلات من العقاب مقابل السلم والأمان»، من جانب آخر. لذلك يتمثّل التحدي الأول ضمن هذا المستوى في الضعف البنيوي و/أو الوظيفي للحكومات الانتقالية، وما يترتب عليها من أخطاء مرحلية تتعلق بالقرارات والتعيينات والتشكيلات الحكومية، وكذلك بإدارة المرحلة الانتقالية، أما التحدي الثاني فيكمُن في ضعف «الحكومة الانتقالية»، أو انعدام الإرادة السياسية لتنفيذ عملية حقيقية ومتكاملة لعدالة انتقالية في البلاد.
عادة ما تستخدم الحكومات الانتقالية تبريرات من قبيل أولوية توفير الخدمات الأساسية أو ضمان الأمن… إلخ، وكأن تنفيذ هذه الأولويات يجب أن يحدث بالتراتب، ولا يمكنه أن يتزامن مع إجراءات العدالة الانتقالية. وفي كثير من التجارب الدولية تشكلت الحكومات الانتقالية من الأطراف التي كانت تتنازع، وبالتالي لم يكن من مصلحة أي طرف فتح ملفات الماضي، لأنها في الغالب متورطة في الجرائم والانتهاكات. وخير مثال على ذلك هو لبنان، وما ذكرناه في المقال السابق عن الاتفاق الشهير لتقاسم السلطة طائفياً، والذي سمي بـ«اتفاق الطائف»، أو كما يحدث في كولومبيا، حيث اتفق الطرفان المتنازعان على إنهاء النزاع ونسيان الماضي بما فيه من انتهاكات قام بها كلاهما.
التحدي الثالث في هذا المستوى يتمثل في ضعف أو انعدام الخبرات والموارد المالية والبشرية، إذا أن تعقيدات عملية العدالة الانتقالية تتطلب الكثير من الخبرات والموارد المالية والبشرية، وعمادها هو القضاء والسلطات التشريعية وقوى إنفاذ القانون. وبالنظر إلى سوريا، نجد أن هذه العملية لا يمكن أن تنفذ بالشكل المطلوب بما تملكه سوريا وحدها اليوم من قضاة ومحققين* جنائيين وكوادر طب شرعي وتشريحي وأجهزة شرطية، فهذه الكوادر ستكون بالكاد قادرة على الاستجابة للقضايا الجنائية والجزائية المتراكمة منذ 2011. إضافة إلى تحدٍ جديد يتمثل بتعريف من هو «القاضي»، فمنذ عام 2012 تأسست محاكم «شرعية» (من «شريعة» وليست شرعية بمعنى قانونية) يُمثل فيها رجال الدين دور «الشرعيين» أو «القضاة»، حيث عيّنت الحكومة «المؤقتة» عدداً من هؤلاء الشرعيين كقضاة ووزير عدلٍ ورئيسٍ لمحكمة النقض. وهذا التحدي كبير ليس فقط نظراً لطبيعة هذه المناصب، وإنما أيضاً للمرجعية المتعلقة بالقوانين القضائية نفسها، هل هي القوانين الجزائية والجنائية الحالية أم وفقاً للشرع الإسلامي؟
أما التحدي المالي المتعلق بتكاليف العدالة الانتقالية فهو تحد بالغ الأهمية. سوريا اليوم، ووفق تقديرات البنك الدولي، تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، فكيف سنتمكّن من تمويل تحقيقات وجمع أدلة واعتقالات ومحاكمات وتعويضات؟ ليبيريا عانت من تحدٍ مالي مشابه، واعتمدت بعد انتهاء حربها الأهلية على تمويل دولي لإطلاق «لجنة الحقيقة والمصالحة»، لكن هذا التمويل جاء بشروطٍ دولية أثارت جدلاً في البلاد حول «الوصاية الخارجية»، ويتردد السوريون* اليوم في تكرار تجربة مشابهة، لكن قد يكون الدعم الدولي، مع ضمان الشفافية، خياراً لا بدّ منه. هناك بالتأكيد خيارات كثيرة ممكنة لتمويل جزء من هذه العملية، مثل خيار تضمين ضريبة مضافة للعدالة الانتقالية على بضائع وخدمات ترفيهية في البلاد، أو إنشاء صناديق تبرعات وأعمال خيرية، إضافة إلى فرص أخرى سنتحدث عنها في مقال آخر مخصص للـ«الفرص».
تحد آخر ضمن هذا المستوى من المهم أن نسلط الضوء عليه، وهو الوثائق وآليات التعامل معها. معظمنا شاهد تلك الفيديوهات واللقطات التي تظهر الناس يقتحمون الفروع الأمنية والسجون وبعض المؤسسات الحكومية، ويأخذون ويصورون بطاقات شخصية وجوازات سفر وقوائم تتضمن أسماء وبيانات مختلفة، بالإضافة لوثائق حكومية واستخباراتية وأمنية. تلك المشاهد حدثت سابقاً في مدن أخرى عام 2012 و2013، وظننا أننا تعلمنا الدرس ولن نكررها، لكنها حدثت وما زالت تحدث. هذه الوثائق في معظمها هي وثائق بالغة الأهمية لعملية العدالة الانتقالية، ورغم أن بعضها صُوِّر وتم تداوله إلكترونياً، إلا أن القيمة القانونية لهذه الوثائق تتمثل في وجودها الفيزيائي، فالوثيقة بحد ذاتها قد تكون دليلاً قوياً، ولكن تتعزز قوتها بشكل كبير عندما تكون مصحوبة بسجل يثبت سلسلة حيازتها، والذي يعرف بـChain of Custody، ويوضح كيف تم الحصول على الوثيقة، ومن كان مسؤولاً عن حيازتها في كل مرحلة، وكيف تم نقلها أو حفظها، وهل تعرّضت لأي تعديل أو تلاعب.
تأتي أهمية سجل سلسلة حيازة الوثيقة من ضمانه بأن الوثيقة لم يتم التلاعب بها أو تغيير محتواها، حيث يوفر الشفافية والمصداقية ويضمن عدم إساءة استخدام الوثائق بطرق قد تُعرّض الضحايا أو الناجين* للخطر، مما يجعلها مقبولة قانونياً. لذلك، من المهم تأسيس هيئة مركزية وشاملة تضم ممثلين* عن المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا ومؤسسات المجتمع المدني، يشمل دورها توحيد معايير جمع الوثائق وأرشفتها وتوثيق سلسلة حيازتها، وكذلك تدريب الأفراد العاملين* في الميدان على كيفية جمع الوثائق بشكل آمن، وإنشاء السجل وتحديثه. وأيضاً تطوير أنظمة إلكترونية مؤمنة لأرشفة الوثائق والسجلات والاعتماد على تقنيات التشفير لتأمينها ومنع التلاعب بها، وهنا يجب التأكيد على المسارعة في أخذ زمام المبادرة، خاصة في ظل غياب البنى المؤسساتية القادرة على القيام بهذا الدور بشكل مستقل.
2– صعوبات متعلّقة بالملفات التي ستتناولها العدالة الانتقالية:
كثيرة هي الملفات التي تقع ضمن ولاية العدالة الانتقالية، لكن تحديد الملفات التي ستُعالجها العملية وتحديد أولويات هذه الملفات وإطارها الزمني يجب ألا يكون منوطاً بالجهات التي ستدير العملية فقط، ولا بتوفر الإيرادات والموارد اللازمة للقيام بذلك، إذ لا بدّ من التأكيد على أهمية التنظيم المجتمعي ككل للضغط والمساهمة الفعالة في عملية العدالة الانتقالية، خاصة مجموعات الضحايا وأهاليهم*، بحيث تكون شريكاً أساسياً في تخطيط وتنفيذ العملية.
يعتبر ملف انتشار السلاح وعشوائيّته من الملفات الأكثر إلحاحاً ضمن مسار العدالة الانتقالية، إذ يلعب دوراً مهماً في الانتهاكات التي ما زالت تحدث بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024. وهو من الملفات المهمة التي تتناولها عملية العدالة الانتقالية، أي نزع السلاح، بمعنى نزع صفة «المقاتل» عن المقاتلين*، وإعادة دمجهم* في الحياة العامة، أي إعادة مدنيتهم*. بالطبع سيكون هناك مقاتلون* لا يرغبون في العودة إلى الحياة المدنية، وسيكون الجيش السوري الجديد بحاجة إليهم*، لكن هذه العملية تتطلب إجراءات محددة أيضاً، تدعى التحري أو التدقيق (Vetting)، وتتضمن إجراء تحقيقات لضمان عدم ارتكاب هؤلاء المقاتلين* لانتهاكات خطيرة أو جرائم، وهو إجراء بالغ الصعوبة بالمناسبة. الغاية من ذلك ضمان أن يكون الجيش الجديد خال من مرتكبي جرائم محتملين*، وكذلك الالتزام بمعايير حقوقية تضمن بناء الثقة بهذا الجيش، وعدم تكرار ما حدث في السابق من تدخل الجيش في الحياة العامة وارتكاب الانتهاكات والجرائم.
نلاحظ اليوم في سوريا أن عدد الأفراد الذين يحملون السلاح في الشوارع كبير للغاية، خاصة في الأرياف أو في مدن مثل درعا وإدلب وغيرها، وهو سلاح غير منضبط في الغالب، وعليه يوجد جرائم قتل واعتداءات بوتيرة يومية. بعض ممن يحملون السلاح هم مقاتلون*، وبعض آخر مدنيون اضطروا إلى حمله لضمان الأمان والدفاع عن النفس، في ظل غياب جهات شرعية تضمن الأمن وتتمتع بالمصداقية والثقة لدى المجتمعات المحلية. أياً يكن المبرر، لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، ويجب جمع هذا السلاح واستعادته من قبل «السلطات الشرعية» في البلاد. لكن ذلك لن يكون بالأمر اليسير، فالكثير ممن يحملون* السلاح «يملكونه» ولن يتخلوا* عنه بلا مقابل، وآخرون* لن يتنازلوا عنه طواعية حتى بمقابل مادي.
في حديث أجرته صديقتي مع سائق تاكسي يحمل سلاحاً فردياً، أخبرها بأنه لن يتنازل عن سلاحه حتى يشعر بالأمان، مع أنه يقيم في منطقة بريف دمشق لم تسجل أي حوادث أمنية أو جنائية.
لم تحاول السلطات السورية الجديدة فتح هذا الملف بعد، بجدية، في مناطق مثل حلب وإدلب ودرعا ودمشق والسويداء، بينما تقوم بحملات لجمع السلاح والمطالبة بتسليمه في محافظات أخرى مثل حمص وحماة وطرطوس واللاذقية. في لقاءاتي مع مجموعات من حمص وحماه أخبروني أن السلطات تسترد السلاح الذي تم استلامه من النظام السابق وليس السلاح الذي تم شراؤه ويعتبر ملكية خاصة، (لم أستطع التحقق من مصداقية هذه المعلومة لكنها تواترت من أكثر من مصدر بمناطق مختلفة). تبايُن التعامل مع هذا الملف أدى إلى شعور بعض المجتمعات بالتمييز ضدهم. على سبيل المثال، أخبرتني بعض المجموعات في مدينة سلمية أن السلطات الجديدة جمعت السلاح من المدينة بينما تُرك مع «البدو» في ضواحي المدينة، وأخبروني أيضاً أن هناك «مشاكل وحساسيات تاريخية بين مدينة السلمية والبدو»، وأن حواجز الجيش سابقاً كانت تمنع «البدو» من دخول المدينة، مما جعلهم* يشعرون بالتمييز والغضب، لذلك، ووفقاً لما أخبرتني به المجموعات، حين تم نزع سلاح المدينة بدأ «البدو» باستعراض سلاحهم والقيام ببعض التعديات على سكان المدينة، إضافة لمحاولة خطف لفتاة (لم يتم التحقق فيما إذا كان «البدو» ورائها). حوادث مشابهة تجري في حمص والساحل السوري، وتنذر باحتمالية نشوب صراعات جديدة وعنيفة في أي لحظة بحال عدم معالجة هذا الملف بشكل شفاف وعادل وعاجل.
في هذا الإطار يمكن الاستفادة من تجربة كولومبيا مع أعضاء المجموعات المسلحة والتي تدعى «فارك». منذ عدة سنوات يتم العمل على نزع السلاح الخاص بهذه المجموعات وإعادة دمج مقاتليها* السابقين*، والذي كانوا في الغالب مزارعين* خسروا* أراضيهم*، حيث تقوم الحكومة الكولومبية ببرامج «مقايضة» السلاح بفرص عمل أو أراض زراعية. هذه البرامج قدمت للمقاتلين* السابقين* فرص عمل وتعليم مقابل تسليم أسلحتهم* وأعطتهم* الفرصة لبدء حياة جديدة ومختلفة.
السلاح العشوائي ليس الملف الوحيد ذي الصلة هنا، لكنه الأول نظراً لضرورة وقف الانتهاكات قبل البدء بمعالجتها، وبالتوازي معه، يوجد ملفات أخرى سنتناولها في الجزء الثاني من هذا المقال، وعلى رأسها ملف المفقودين وكشف المصير، كما سنكمل التعمّق في تحديات المستوى الثالث، علّ هذا يُسهم في توضيح أُطر يمكن البدء منها الآن، وفوراً، لضمان مستقبل خالٍ من العنف في سوريا.
———————————–
الجزء الثاني
تحديات في تنفيذ عدالة انتقالية في سوريا (2/2)/ مصطفى حايد
الالتفات إلى الوراء (2)
25-03-2025
ملاحظة الكاتب: تم استخدام صيغة المذكر لسهولة الكتابة والقراءة، لذا أود التأكيد على أن المحتوى يشير للتنوع الجندري والجنساني الذي تشملها التعابير المستخدمة في هذا المقال.
*****
ناقشنا في الجزء الأول صعوبات المستوى الأول وجزء من المستوى الثاني. مقالتنا اليوم ستتابع نقاش تحديات المستوى الثاني والثالث.
نحن نعرفُ الآن أن العدالة الانتقالية ليست عملية بسيطة أو مباشرة، وليست فورية أو قصيرة الأمد، ولا يمكن احتكارها أو الوصاية عليها من قبل الدولة فقط، أو من فئة واحدة ومحددة في المجتمع، إنما هي عملية متكاملة وشاملة وشفافة.
هذه العملية تتطلّب مواجهة تحديات معقدة تتوزع على ثلاث مستويات أساسية: صعوبات متعلّقة بتخطيط وتنفيذ العملية نفسها والجهة المنفذة لها، وتلك المتعلّقة بالملفات التي ستعمل على معالجتها، وصعوبات تتعلّق بالجهات المستهدفة سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات أو المجتمعات.
2- صعوبات متعلّقة بالملفات التي ستتناولها العدالة الانتقالية:
حين فُتحت السجون، اكتشفت الكثير من العائلات أن أحبابَها كانوا أحياء، رغم استلامهم لشهادات وفاة. وآخرون كانوا يرسلون الأموال والطعام واللباس لأحباب ظنوا أنهم أحياء لسنوات، لكن تبين عكس ذلك. وسواء عُرِف مصير بعض المختفين أم لا، ما زال أغلبهم بلا رفات، وحتى الرفات التي يتم العثور عليها، من الصعب الآن التعرف على هويتها والجهة المسؤولة عن قتلها.
وهنا نعود لأهمية الوثائق ودورها في تحديد هويات المخفيين والجناة المسؤولين عن هذه الجرائم. فكما شاهد العديد منا، هناك الكثير من الجثث التي تحمل أرقاماً، وفَهمُ النظام الخاص بهذه الأرقام قد يكون الخطوة الأولى نحو تحديد هويات أصحاب الرفات، والفروع المسؤولة عن تغييبها وتعذيبها وقتلها.
سيحتاجُ هذا الملف لسنوات من العمل وأيضاً الخبرات التي لا تتوفر، للأسف، حتى الآن في سوريا. وحتى تتم معالجة هذا الملف نحن بحاجة ملحة إلى العمل على جمع وحفظ الوثائق والأدلة، وأيضاً حماية المقابر الجماعية والقبور والرفات وأجزائها المتناثرة في أماكن كثيرة ومكشوفة، إلى درجة أن الأطفال والكلاب تلعب بها.
تحديدُ مصير الأشخاص المفقودين ومكان وجودهم يُعدُّ من أولويات عملية العدالة الانتقالية. يشكل هذا الملف أحد أكبر الجراح والمآسي في الصراع السوري. هناك عشرات الآلاف من الأشخاص مجهولي المصير منذ عام 2011؛ بعضهم اعتقلته جهات حكومية مختلفة وأخرى موالية لها، وآخرون اختطفتهم داعش أو فصائل عسكرية مختلفة وحركات جهادية متعددة في مختلف المناطق السورية التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد. كما اختُطف أو قُتل بعضهم على يد عصابات جريمة منظمة وعشوائية، وآخرون اختفوا بعد أن عبروا حدود البلاد من جهاتها المختلفة.
تجربة لبنان في هذا الصعيد غير مبشرة أبداً، ولا نريد أن نرى تجربة مشابهة في سوريا، بحيث يبقى هذا الملف مفتوحاً لعقود دون تحديد مصير مفقودينا، ودون معرفة المسؤولين عن اختفائهم ومحاسبتهم.
ومن المهم أيضاً التأكيد على عدم استخراج أي رفات الآن، لأن المكان، كما هو، يعتبر جزءاً أساسياً من الأدلة، ويقدم معطيات كثيرة تساعد في تحديد سياق ما حدث، وكشف الهوية وتحديد الجناة، إضافة إلى عدم توفر الخبرات اللازمة لاستخراج الرفاة بالطريقة السليمة، كما لا توجد أماكن لحفظها وتأمينها. لكن للأسف، هناك أخطاء كثيرة على هذا الصعيد ترتكبها منظمات مجتمع مدني وجهات إعلامية، وتترتّب عليها أضرار لا يمكن إصلاحها.
تمثل العدالة الانتقالية مفهوماً أوسع بكثير من العدالة الجنائية. فالمساءلة الجنائية الفردية تلعب دوراً رئيسياً في عملية العدالة الانتقالية، لكن جوانب أخرى من المساءلة تعدُّ أيضاً عوامل حاسمة لبلوغ الأهداف الأوسع لهذه العملية. من هذا المنطلق يمكننا فهم الصعوبات الإضافية للتعامل مع هذه الملفات ضمن عملية العدالة الانتقالية، إذ سيواجه المحقّقون والقضاة والمحاكم قضايا جنائية غير اعتيادية، وجرائم كبرى لم يُعمل على مثيلاتها من قبل.
هناك ثلاث فئات رئيسية من الجرائم المصنفة بموجب القانون الدولي: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ولكننا في هذا المقال سنستعرضُ نوعين من الجرائم الكبرى فقط، واللذين سنتعامل معهما ضمن هذه العملية: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
لكي تصنّف الجريمة على أنها جريمة حرب، يجب إثبات مجموعتين من العناصر:
أولاً: وجود نزاع مسلح، أي حرب.
ثانياً: أن يكون الجرم أحد الأفعال المحظورة الواردة في المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنها: استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية عمداً، استخدام أسلحة محظورة، تجنيد الأطفال أو تطويعهم، الاغتصاب، التعذيب وإساءة معاملة الأسرى… إلخ.
ومن أجل إثبات المسؤولية الجنائية الفردية فور تأكيد هذين العنصرين، يجب إظهار أن الجاني كان على علم بأن الفعل المرتكب وقع ضمن سياق الصراع المسلح، أي أنه لم يكن حادثاً عرضياً منعزلاً.
أما الجرائم ضد الإنسانية، فتعني أي فعل من الأفعال المحظورة الواردة في المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عند ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق، أو ممنهج موجّه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وتتضمن مثل هذه الأفعال: القتل العمد، الإبادة، الاغتصاب، الإبعاد القسري للسكان مثل التهجير، التعذيب، اضطهاد أي جماعة لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، والإخفاء القسري للأشخاص.
ويجب أن يتحقق في الفعل الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية العناصر الأربعة التالية:
وقوع هجوم ضد مجموعة من السكان المدنيين.
أن يكون هذا الهجوم واسع النطاق أو ممنهجاً.
ارتكاب الفعل الجرمي كجزء من هذا الهجوم.
أن يكون المتهم أو الجاني على علم بالسياق الأوسع الذي ارتُكب فيه هذا الفعل الجرمي.
وهنا لا يوجد أي شرط لوجود نزاع مسلح أو حرب، فالقانون الذي يحظر الجرائم ضد الإنسانية ينطبق في أوقات السلم كما في أوقات الحرب، وبالتالي، يمكن لبعض جرائم الحرب أن تصنف أيضاً كجرائم ضد الإنسانية. كما أنه ليس من الضروري أن يكون المتهم عضواً في القوات المسلحة لكي يتحمل المسؤولية، إذ يمكن للمدنيين أيضاً أن يكونوا مسؤولين جنائياً عن انتهاكات القانون الجنائي الدولي. ولا تعفي المتهم حقيقة أنه كان يتصرف بناءً على أوامر من الحكومة أو الرئيس من المسؤولية الفردية الجنائية، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يُؤخَذ في الاعتبار وفقاً للمبادئ العامة للقانون في تخفيف العقوبة. ووفقاً لهذه المبادئ الخاصة بالمسؤولية، إذا أُمر قائد بتنفيذ أفعال معينة، فإنه يحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الأفعال. ومن المهم أيضاً أن نذكر أن القانون الجنائي الدولي يَفرض ما يُعرَف باسم «مسؤولية القيادة» (Chain of Command)، وهو المبدأ الذي يكون فيه الرئيس مسؤولاً عن أفعال مرؤوسيه ممن يعملون تحت قيادته.
هناك تشعبات أخرى تتعلق بالمسؤولية المباشرة وغير المباشرة والجرم المشترك لن نخوض فيها هنا، لكن لا بدّ أن نذكر أن هذه الجرائم، أي جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم الزمني، ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائياً حتى خارج بلادهم، وذلك باستخدام آليات قضائية دولية محددة، والغاية من كل هذا الحديث هي توضيح أن الجرائم الكبرى تتطلب توثيقاً وتحقيقاً أكثر تعقيداً من القضايا الجنائية الاعتيادية، مما يضيف بعداً أعمق للتحديات على هذا المستوى.
من الملفات الأخرى المهمة، والتي يجب تسليط الضوء عليها، هي ملفات الجرائم الثقافية والاقتصادية والسياسية، والتي تعود جذورها إلى ما قبل 2011. أبرز هذه الجرائم ارتُكبت بحق المكون الكردي في سوريا، حيث تعرّض الكرد السوريون لعقود طويلة من القمع والحرمان من التحدث بلغتهم بحرية، وإطلاق الأسماء الكردية على أولادهم وبناتهم، وممارسة بعض الطقوس الاجتماعية… إلخ. على سبيل المثال، لدي صديق اسمه الرسمي، وفقاً لبطاقته الشخصية، «جمعة»، في حين أن اسمه المتعارف عليه بين عائلته وأصدقائه الكرد هو «جوان»، إذ لم يُسمح لعائلته بتسجيله رسمياً باسم جوان، وهذه حالة تنطبق على الآلاف من الكرد السوريين. بالإضافة إلى ذلك، هناك عشرات الآلاف ممن لم يتم تسجيلهم رسمياً، ويعتبرون «غير مجنسين» أو بلا جنسية (كنت قد كتبت عن هذا الملف عام 2005 في مجلة «البوصلة»، كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مفصلاً عن هذا الموضوع في العام نفسه).
إلى جانب ذلك، تبنّى النظام السوري، على مدى عقود، سياسات اقتصادية تقشفية في مناطق عيش الكرد، وتحديداً تلك التي يشكلون فيها أغلبية، كما فرض قيوداً صارمة ومنعَ كل ما يتعلق بثقافتهم وأعيادهم القومية. هذا الملف يعتبر من أكثر القضايا إثارة للانقسامات بين السوريين، وسيشكّل تحدياً بالغاً أثناء التعامل معه.
3- صعوبات تتعلق بالجهات المستهدفة:
أهم تحديات هذا المستوى تتمثل في الوعي المحدود بعملية العدالة الانتقالية وأهميتها وتعقيداتها، إضافة إلى الانقسامات المجتمعية. وتنعكس نتائج هذه التحديات في السرديات المختلفة لما حدث في سوريا منذ 2011، والمفاضلة والكيل بمكيالين، وكذلك تنميط الضحايا والجناة، إلى جانب للشائعات والتضليل الإعلامي.
في مجتمع متنوع مثل سوريا، تختلف مفاهيم وأولويات العدالة بشكل كبير بين المجتمعات والمدن المختلفة؛ ففي المناطق التي عانت من العقاب الجماعي، كالحصار والقصف الجوي، قد تكون الأولوية بالنسبة إلى سكانها هي محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات، أما في المناطق التي عانت تاريخياً من التمييز والحرمان، فقد تكون الأولوية هي الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية. وفي مناطق أخرى، قد يرى البعض أن الأولوية هي الحفاظ على الاستقرار وعدم فتح ملفات الماضي، خوفاً من الانتقام الفردي وانتشار العنف الأهلي، بينما في مناطق أخرى قد تكون الأولوية هي إعادة ترميم المنازل والعودة إليها، والتعويض وجبر الضرر.
ولا يمكننا القول إن بعض هذه الأولويات صحيح وبعضها الآخر خاطئ، أو بعضها ملحٌّ بينما الآخر يمكن أن ينتظر. لذلك، من المهم إجراء مشاورات مجتمعية مختلفة لفهم وجهات النظر المختلفة، والعمل معاً على تخطيط عملية تحترم هذه الاختلافات وتأخذها بالحسبان، من خلال نهج متكامل وتشاركي.
يضاف الى ما سبق تباينُ السرديات عما حصل في سوريا عموماً، وفي كل منطقة على وجه الخصوص، وكذلك تباين الروايات حول كيف تطورت الأمور منذ عام 2011 إلى اليوم، وكيفية النظر إلى القوى السياسية والعسكرية والدينية والإثنية المختلفة.
ما حدث في الساحل السوري في آذار (مارس) ٢٠٢٥ من مجازر وانتهاكات يُبيّن حجم الانقسام والاختلاف بين السوريين من كافة المناطق والمكونات والإيديولوجيات في رؤيتهم لما حدث، وفي مسألة مُساءلة المسؤولين عن ذلك. فالسوريون اليوم أيضاً منقسمون حول من هو «القتيل» ومن هو «الشهيد»، ومن هم «الأبطال» ومن هم «المجرمون»، ومن هم «الضحايا» ومن هم «الجناة». وسيختلفون كذلك حول هذه هذه الفقرة ضمن المقال وسيهاجمُها كثيرون ممّن سيعتبرون أن هذا النقاش مجحف بحق «الضحايا» وبحق ما حصل في سوريا، لأنه موضوع «واضح وغير قابل للنقاش أصلاً».
بعض هذه الاختلافات والنقاشات ستكون سلمية وصحية، ولكن بعضها أيضاً سيكون عنيفاً وقد يصبح دموياً، ومن هنا تأتي أهمية تناول هذا الملف ومعالجته. أحد خبراء العدالة الانتقالية في المانيا ذكر، خلال أحد اللقاءات، أن أهم خطوة اتُّبعت في ألمانيا الموحدة بعد هدم جدار برلين الفاصل بين ألمانيا الشرقية والغربية، كانت الاتفاق على الحكاية أو السردية حول «قصة ما حدث». وسيكون هذا أيضاً من أهم الخطوات الأولى التي يجب أن نتفق عليها في سوريا، ولن يكون ذلك ممكناً دون حوارات مجتمعية كثيرة، وأحياناً قاسية.
هذا الانقسام ليس جديداً أو حكراً على الوضع في سوريا، ففي رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اختلفت روايات الضحايا والجناة حول «من بدأ العنف أولاً». الحل الذي اتبعته رواندا كان إنشاء برامج حوارية وتوعوية في المدارس وأماكن العبادة لتعريف الجميع بمفهوم العدالة المشتركة، وساعدت هذه البرامج في بناء لغة مشتركة بين الضحايا والجناة. في لبنان أيضاً تتباين الروايات حول ما حدث خلال الحرب الأهلية، وإلى اليوم لم يتم الاتفاق على سردية مشتركة، وبسبب ذلك، لا يتم تدريس هذه الفترة من تاريخ الى الآن.
في سوريا، نحن بحاجة ماسة لبرامج استشارية وتوعوية وحوارات مجتمعية تُسهم في بناء لغة وسرديات مشتركة. يمكن البدء بمبادرات محلية (وبعضها قد بدأ بالفعل، مثل مجموعة السلم الأهلي في حمص وبعض المبادرات المدنية في طرطوس) تنطلق من نقاشات مجتمعية بين الأحياء، ثم تتوسع لتشمل أحياء أخرى ضمن المنطقة. ثم يمكن لهذه المبادرات، بعد أن أصبحت تمثل مختلف المناطق، أن تبدأ بلقاءات تنقاشُ وتحاججُ خلالها سلمياً، بحيث تنتهي بحوارات على المستوى الوطني وفق نهج تصاعدي، من قاعدة الهرم إلى قمته.
ومن المهم هنا إدراك أن مثل هذه الحوارات تتطلب ميسرين ومديرين للحوار يتمتعون بمهارات اجتماعية وحوارية عالية، مع اطلاع واسع وحرص على مبدأ عدم الضرر وضمان السلامة. فرغم أهمية هذه والحاجة الماسة إليها، قد تنحرف في الاتجاه الخاطئ إذا لم تدار بحكمة، مما قد يحولها إلى تجمعات تحريضية مليئة بالكراهية والطائفية والانقسامات، بدلاً من تكون جامعة. وسيكون التوقيت، وضمان توفير مساحات آمنة، والاعتماد على مهارات خاصة في إدارة الحوار وظروفه، عوامل بالغة الأهمية لضمان نجاح هذه العملية.
بُعدٌ آخر مهم ضمن هذا المستوى، لكنه يمتد للمستويات الأخرى أيضاً، وهو موضوع الشائعات والتضليل الإعلامي. أغلبنا على اطلاع على حجم الشائعات والتضليل والمعلومات المغلوطة منذ عام 2011، لكننا اليوم، وفي المستقبل القريب أيضاً، نشهد وتيرة متزايدة من الشائعات الممنهجة، إضافة إلى التضليل المتعمّد والفيديوهات والأخبار المزيفة التي تهدف إلى نشر الكراهية والتحريض على العنف.
في أغلب الحروب والصراعات، يتم الربط بين العفو وبناء السلام، وليس بين العدالة وبناء السلام، وينبعُ ذلك من مبدأ أن معظم، إن لم يكن جميع، الأطراف المتصارعة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي نفسها التي تجلس على طاولة المفاوضات أو يفوز أحدها في النهاية، سواء كان طرفاً واحداً أو تكتلاً من الأطراف، ولكل من هذه الأطراف «إعلامٌ حربيٌّ» يدور في فلكها، ويملك موارد بشرية ومادية لا يستهان بها.
هذه الشبكات الإعلامية، إلى جانب أخرى فردية وعشوائية وغير ممنهجة، تنشطُ دائماً قرب الأحداث الكبرى أو المفصلية، وغالباً ما يكون يكون السلم المجتمعي والعدالة والمساءلة من أبرز ضحاياها أو مستهدفيها. لذلك، يُعدُّ الإعلام المستقل والاحترافي ضرورة لا غنى عنها، ليس فقط في مراحل التحول والانتقال، بل أيضاً في الحد من هذه التحديات وتوفير معلومات ذات مصداقية.
إن مراجعة سريعة لكل ما تم ذكره في الجزأين الأول والثاني من صعاب، تُبيّن أن القاسم المشترك لمعالجتها يتمثل في إجراء حوارات ومشاورات مجتمعية. حوارات تبدأ ضمن المستويات المحلية الصغيرة على مستوى المناطق والبلدات، ثم تتوسع تدريجياً لتشمل المدن والمحافظات، وصولاً إلى المستوى الوطني الشامل.
هنالك العديد من التجارب المشابهة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، حيث أجرت دول مثل رواندا وسيراليون وأفغانستان مشاورات وطنية واسعة النطاق، نتج عنها بناء استراتيجيات وبرامج وطنية ساعدت في تشكيل عملية عدالة انتقالية تشاركية وفعّالة. المجتمع المدني السوري يمتلك الكثير من الخبرات للبدء بهذه العملية، ويجب عليه اليوم قبل الغد المباشرة بها في مختلف المناطق السورية.
———————————
الجزء الثالث
تنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا/ مصطفى حايد
الالتفات إلى الوراء (3)
08-04-2025
*ملاحظة الكاتب: تم استخدام النجمة الجندرية للإشارة إلى التنوع الجندري والجنساني الذي تشملها التعابير المستخدمة في هذا المقال*
*****
تناولنا في المقالات السابقة ضمن هذه السلسة مفهوم العدالة الانتقالية وطبيعتها الهجينة، واستعرضنا بعضاً من التحديات الأساسية التي قد تواجه تطبيقها في سوريا. هذا المقال، وهو الثالث من سلسلة مكونة من خمس مقالات (نُشرَ الثاني منها على جزئين)، سيتناولُ الجوانب العملية لتنفيذ العدالة الانتقالية، كالتوقيت والنطاق والآليات المختلفة التي يمكن استخدامها، وكيفية تصميم نموذج سوري يراعي خصوصيات السياق المحلي.
في آذار (مارس) 2025، استفاق السوريون على مجازر وحشية في قرى ومدن في الساحل السوري: جثث مرمية في الشوارع، منازل محترقة، عائلات بأكملها قُتلت بدم بارد، وذلك في تكرار لمجازر اعتقد البعض أنها أصبحت جزءاً من الماضي بعد سقوط نظام الأسد. هذه المجازر لم تكن مجرد أحداث منفصلة، بل هي امتداد لعقود من الإفلات من العقاب، ومن غياب العدالة، ومن استمرار العنف دون مساءلة.
وبدلاً من أن يتوحّد السوريون* في فهم ما حدث وإدانته والحداد عليه، انقسموا* بين مشكك ومهلل ومبرر ومستاء وصامت. تحدّثنا عن هذه الانقسامات في المقال السابق كأحد أهم التحديات التي تواجه عملية العدالة الانتقالية في سوريا، ولكن لم نتوقع أن تتعمّق أكثر خلال أسابيع قليلة فقط. إضافة إلى هذا الانقسام وتبعاته، تشكل هذه الأحداث الأليمة تذكيراً بالغاً للجميع بأن الماضي لم ينتهِ بعد، وأن الجرائم قد تتكرر مجدداً.
في الأيام الماضية، كان كثير من السوريين* يتساءلون: هل سيحاسَب القتلة هذه المرة؟ أم أن هذه الدماء ستذهب كما ذهبت دماء آلاف السوريين من قبل. وهو تساؤل في صلب العدالة الانتقالية التي لا تقتصر على مجرد محاكمات، بل هي عملية طويلة ومعقدة، تبدأ بالكشف عن الحقيقة، لكنها لا تكتمل إلا عندما يشعر الضحايا أن صوتهم سُمع، وأن المجرمين حوسِبوا، وأن هكذا جرائم لن تتكرر.
من هذا المنطلق، تصبح العدالة الانتقالية أداة للحفاظ على ما تبقى من نسيج المجتمع، ولمنع المستقبل من أن يصبح تكراراً للماضي. كيف يمكن لسوريا أن تواجه هذا الإرث الدموي؟ متى يبدأ العمل على تحقيق العدالة؟ وما هي الوسائل التي يمكن تبنيها لضمان عدم التكرار؟ هذا ما سيناقشهُ مقال اليوم.
التوقيت والنطاق
أحد أهم الانتقادات التي وُجّهت إلى حكومة تصريف الأعمال السورية كانت إعطاء أولوية العفو على عملية متكاملة للعدالة الانتقالية، وبذلك وضعت نفسها في مواجهة هذه العملية لا كجزء منها، إضافة إلى احتكار القرار وسرعته وسؤال مدى مشروعيته في موضوع مصيري كهذا. ذُكِر العفو والمسامحة منذ التصريحات والمقابلات الأولى التي أجرتها الجهات الرسمية الجديدة، في حين لم تُذكَر العدالة الانتقالية إلا بعد أيام. وحتى حين ذُكِرت، لم تتم، حتى لحظة كتابة هذا المقال، الاستفاضة بالحديث عن ماهيتها وإطارها الزمني ومدى شموليتها وطبيعة تنفيذها.
يعدُّ سؤال التوقيت من أكثر الأسئلة إلحاحاً في مسار العدالة الانتقالية؛ فهل ننتظر استقرار الوضع الأمني والسياسي بشكل كامل قبل البدء بعملية العدالة الانتقالية، أم نبدأ فوراً بالعمل على جوانب معينة منها؟
تجارب الدول تُقدم دروساً متباينة. في تشيلي، انتظر المجتمع نحو عقد من الزمن، بعد سقوط نظام بينوشيه، قبل أن تبدأ محاكمات واسعة النطاق. وكان ذلك انتظاراً استراتيجياً للسماح بترسيخ المؤسسات الديمقراطية أولاً. بينما في الأرجنتين، بدأت لجنة الحقيقة «CONADEP» عملها بعد أقل من أسبوع من انتهاء الحكم العسكري، وأنتجت تقريرها الشهير «لن يتكرر ذلك أبداً Nunca Más» خلال عام واحد فقط. وفي رواندا، بدأت المحاكم فور انتهاء الإبادة الجماعية عام 1994. وكذلك بدأ مسار العدالة الانتقالية في كولومبيا بالتوازي مع مفاوضات السلام مع مجموعات «فارك» العسكرية.
في سوريا، يمكن القول إن العمل على بعض مسارات العدالة الانتقالية قد بدأ فعلياً منذ سنوات، خاصة في مجال التوثيق وجمع الأدلة الذي تقوم به عشرات المنظمات السورية والدولية. وقد نجح هذا العمل في تحقيق بعض الإنجازات، لكن خارج سوريا، مثل محاكمة أنور رسلان في ألمانيا عام 2021 وغيره ضمن محاكمات أخرى جرت، وما زال بعضها جارياً، في ألمانيا وفرنسا والسويد.
تخبرنا هذه التجارب المختلفة أنه لا داعٍ للانتظار حتى تستقر كل الأمور قبل أن نبدأ في تنفيذ عملية العدالة الانتقالية، فحين نتحدث عن المسارات غير القضائية، كالتوثيق وجمع الأدلة وتقصي الحقائق وحفظ الذاكرة، يمكن ويجب البدء بها فوراً. أما المسارات القضائية، فقد تحتاج لبيئة مؤسساتية مستقرة، لكن التحضير لها من خلال تدريب الكوادر القضائية وتجهيز البنى التحتية لا يحتمل التأخير ويجب البدء بتنفيذه الآن.
من التحديات المهمة التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا هي طول الفترة الزمنية التي شهدت انتهاكات، وتعدد الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات. فكما ذكرنا في المقالين السابقين، تمتدُّ جذور بعض هذه الانتهاكات إلى ما قبل 2011، بينما وقعت انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة منذ بداية الانتفاضة وحتى يومنا هذا.
النقاش حول خط البداية ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو جدل مجتمعي وسياسي. الكثير من السوريين* اليوم لا يثقون بأي عملية عدالة انتقالية إذا لم تكن شاملة، وتستهدف جميع من تورطوا في الجرائم الكبرى التي وقعت بعد سقوط نظام الأسد، بما فيها جرائم آذار (مارس) 2025. آخرون يخشون أن تؤدي المحاكمات إلى انتقائية تزيد من الشروخ المجتمعية بدلاً من معالجتها. لهذا، السؤال المهم هو كيفية تحديد الأولويات دون الوقوع في فخ «عدالة المنتصرين» أو «العدالة الانتقامية» أو «العدالة الانتقائية أو التمييزية».
تجربة البيرو قد تقدم نموذجاً مفيداً في هذا السياق، فقد واجهت تحدي التعامل مع انتهاكات امتدت لعقدين من الزمن (1980-2000) وتنوعّت بين ما ارتكبته قوات الأمن الرسمية وما قامت به المجموعات المسلحة. فتبنّت البيرو نهجاً مرحلياً للتعامل مع هذا التحدي، حيث قسّمت عملها إلى مراحل زمنية وجغرافية، وركزت على أنماط الانتهاكات بدلاً من كل حالة فردية. أما في المغرب فقد حددت هيئة الإنصاف والمصالحة نطاقاً زمنياً لمعالجة الانتهاكات بين عامي 1956 و1999. وفي تونس، ركزت العدالة الانتقالية على فترة تمتد من 1955 حتى 2013، مما سمح للضحايا من مختلف الأجيال بالحصول على فرصة لسرد معاناتهم. أما في رواندا، فواجه المجتمع تحدياً مشابهاً، حيث لم يكن القتلة فقط من النظام، بل من أفرادٍ داخل المجتمع نفسه، ما دفع الدولة إلى تبني نهج مزدوج يجمع بين العدالة القضائية والمجتمعية. كانت رواندا أمام تحدي محاكمة مئات الآلاف من المشتبه بمشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994، ونظراً لاستحالة محاكمة هذا العدد الهائل عبر المحاكم التقليدية، ابتكرت رواندا نظام «غاكاكا» المستوحى من التقاليد المحلية للعدالة المجتمعية، بحيث سمح هذا النظام بمحاكمة أكثر من مليون شخص على مدى عشر سنوات. لكن هل سيكون هذا النهج ممكناً في ظل الانقسامات العميقة في المجتمع السوري، وفيما بين المدن المختلفة في سوريا؟
النهج
قد لا تكون العدالة الانتقالية قادرة على معالجة كل الانتهاكات التي حدثت بالعمق نفسه وفي الوقت نفسه. لذلك، من الممكن تحديد أهداف واضحة وواقعية، ووضع أولويات تستجيب للاحتياجات الملحة للمجتمع السوري وفق المعايير التالية:
1- خطورة الانتهاكات: إعطاء الأولوية للجرائم الأشد خطورة؛ كالقتل الجماعي والتعذيب الممنهج والاختفاء القسري.
2- الاستمرارية: التركيز على الانتهاكات المستمرة التي ما زالت آثارها قائمة، مثل ملف المعتقلين والمختفين قسراً.
3- النطاق: الاهتمام بالانتهاكات واسعة النطاق التي طالت شرائح كبيرة من المجتمع.
4- قابلية المعالجة: البدء بالقضايا التي يمكن إحراز تقدم فيها بشكل أسرع، مثل التعويضات المادية لضحايا انتهاكات محددة.
5- القيمة الرمزية: اختيار قضايا ذات رمزية عالية يمكن أن تساهم في بناء سردية مشتركة للتاريخ السوري المعاصر.
لنفترض أننا حددنا النطاق الزمني وكذلك المعايير، السؤال التالي سيكون: كيف يمكن التعامل مع انتهاكات ارتكبتها جهات متعددة، وليس فقط النظام؟ ماذا عن الجرائم التي ارتكبتها جماعات مسلحة أخرى؟ كيف يمكن تحقيق العدالة دون أن تتحول المحاكمات إلى ساحة انتقام؟
النهج الأكثر واقعية لسوريا للاستجابة لهذه الأسئلة قد يتمثل في استراتيجية متعددة المستويات تشمل:
1- تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح قوانينها بذلك (كما يحدث حالياً في ألمانيا والسويد وفرنسا).
2- العمل على إنشاء محكمة مختلطة/هجينة (سورية دولية) للتعامل مع أخطر الجرائم.
3- بناء قدرات المحاكم المحلية للتعامل مع القضايا الأقل تعقيداً.
4- الاستمرار في الجهود لإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لجان الحقيقة
وفي هذه الأثناء، من الضروري العمل على إطلاق لجان الحقيقة، التي تعتبر من أهم آليات العدالة الانتقالية غير القضائية، والتي تهدف إلى توثيق الانتهاكات وكشف الحقائق وبناء سردية مشتركة.
انتظرت جنوب أفريقيا حتى نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994 لبدء محاكماتها، لكنها بدأت فوراً بتشكيل «لجنة الحقيقة والمصالحة». التبكير سمح بمنع تدمير الأدلة وتهريب المجرمين. كما سمحت لجان الحقيقة للضحايا بسرد قصصهم أمام الجناة، ما ساهم في كسر حاجز الخوف، حيث جلس الضحايا والجناة وجهاً لوجه واضطرّ القتلة للاعتراف بجرائمهم مقابل احتمال الحصول على العفو. هل من الممكن إجراء جلسات مشابهة في سوريا؟
مهما كان السيناريو الذي ستختاره سوريا في اختيار مسار لجان الحقيقة، على هذه اللجان أن تتميز بالخصائص التالية:
1- تمثيل متوازن لمختلف المناطق والمكونات السورية.
2- صلاحيات واسعة للتحقيق والوصول إلى المعلومات.
3- تبني نهج الضحايا أولاً، مع توفير مساحات آمنة للإدلاء بالشهادات.
4- التكامل مع المسار القضائي، من خلال تحديد واضح للعلاقة بين اللجنة والمحاكم.
5- آليات حماية فعالة للشهود والضحايا.
عدم التكرار
بالعودة لمجازر الساحل السوري في آذار 2025، يجب العمل الفوري والجدي والفعال لضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال التحقيق الشفاف فيما حدث، والاعتراف به، وتحمل مسؤوليته، ومحاسبة الجناة. ولضمان عدم التكرار، لا بد من إصلاح المؤسسات التي كانت متورطة فيها، أو التي كان من المفترض أن تمنع وقوعها. إصلاح المؤسسات يجب أن يشمل:
1- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وضمان وجود آليات جدّية تضمن الالتزام بالقوانين الدولية وتحترم حقوق الإنسان وتضمن الشفافية والمساءلة. يمكن هنا الاستفادة من تجربة كولومبيا في إصلاح الشرطة (2016-الآن) حيث قامت بتدريب العناصر على حقوق الإنسان. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتدريب كوادر جديدة، وإنشاء آليات رقابة فعالة، هي شروط لا بد منها لضمان عدم تكرار المجازر مستقبلاً. قد يكون أحد النماذج الممكنة هو الاستفادة من التجربة الألمانية في التعامل مع «شتازي» بعد سقوط جدار برلين، حيث فُتحت ملفات المخابرات، وأُتيح للضحايا الاطلاع على الوثائق التي تكشف من كان مسؤولاً عن تعذيبهم أو ملاحقتهم.
2- فحص سجلات العاملين في هذه المؤسسات وفي كل المؤسسات الحساسة.
3- إصلاح النظام القضائي لضمان استقلاليته.
4- تطوير آليات رقابية فعالة، بما يشمل دوراً للمجتمع المدني.
5- تعديل التشريعات التي سهلت ارتكاب الانتهاكات أو تلك التي قد تسهل الإفلات من العقاب.
المشاورات والمشاركة
لا يمكن أن تنجح العدالة الانتقالية دون مشاركة واسعة من المجتمعات المحلية والضحايا وأهاليهم*. تجربة تونس في هذا المجال مفيدة، حيث أجرت هيئة الحقيقة والكرامة مشاورات وطنية شاملة قبل تحديد آليات عملها. وكانت نتائج استطلاعات الرأي في تونس، التي أجرتها «هيئة الحقيقة والكرامة» لمعرفة أولويات الضحايا، مُفاجئة، حيث فضل 60 بالمئة الاعتذارَ العلني على التعويض المادي. آما رواندا، بعد الإبادة، فنظمت حكومتها حواراتٍ في القرى بإشراف «أمناء الذاكرة» من كبار السن. هل بالإمكان تطبيق ذلك في سوريا؟ بحيث تلعب المجالس المحلية دوراً مماثلاً؟
ولضمان المشاركة المتساوية والعادلة لا بد من ضمان:
1- إجراء مشاورات على مستويات متعددة (محلية، إقليمية، وطنية).
2- تطوير آليات مشاركة تصل إلى المناطق النائية والفئات المهمشة.
3- تمثيل متوازن لمختلف المناطق والمكونات والفئات الاجتماعية.
4- الدور الجندري وأهمية المشاركة المتساوية والفعالة للنساء في هذه العملية.
5- الاستفادة من دور المجتمع المدني السوري في تيسير المشاركة المجتمعية.
6- إشراك السوريين في المهجر من خلال آليات مشاركة عن بعد.
في الختام، ما حدث في الساحل في آذار 2025 ليس مجرد جريمة أخرى تُضاف إلى قائمة طويلة من الفظائع. إنه جرس إنذار بأن العدالة لم تعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة ملحة. التاريخ يخبرنا أن المجتمعات التي واجهت ماضيها بشجاعة، هي التي استطاعت بناء مستقبل مستدام.
إن العدالة الانتقالية ليست فقط محاكمات، وليست فقط لجان حقيقة أو تعويضات. إنها وعدٌ للضحايا بأن ما حدث لهم لن يحدث مجدداً، وأن سوريا الجديدة ليست استمراراً لما قبلها. إنها اعتراف بأن هناك مظالم يجب تصحيحها، وأن العدالة ليست رفاهية يمكن تأجيلها، بل شرط أساسي لأي مستقبل مستقر.
————————————
الجزء الرابع
العدالة الانتقالية: الشرعية والشفافية والمشاركة/ مصطفى حايد
في الالتفات إلى الوراء (4)
02-05-2025
تنويه من الكاتب: تم استخدام صيغة المذكر لسهولة الكتابة والقراءة، لذا أود التأكيد على أن المحتوى يشير للتنوع الجندري والجنساني الذي تشمله التعابير المستخدمة في هذا المقال.
*****
في الأجزاء الثلاثة السابقة، حاولنا رسم ملامح العدالة الانتقالية في سوريا كعملية مُركَّبة، تتجاوز حدود المحاكم والعقوبات لتلامس احتياجات الناس في الحقيقة، والاعتراف، والمصالحة، وضمان عدم التكرار. تناولنا في الجزء الأول المفهوم الأساسي للعدالة الانتقالية في السياق السوري. وفي الجزء الثاني (نُشِرَ على قسمين 1و2) استعرضنا التحديات المتعددة التي تواجه تطبيقها، من ملفات المفقودين إلى السرديات المتضاربة. أما في الثالث فقد حاولنا رسم معالم تنفيذية لهذه العملية على الأرض، مع دروس مستفادة من تجارب دول أخرى. في هذا الجزء الرابع، نفتح النقاش على مسألة الشرعية، والمشاركة، والمُلكية المجتمعية، كأُسس ضرورية لنجاح عملية سوريّة للعدالة الانتقالية تنبثق من الواقع السوري ولا تفرض عليه.
* * * * *
عندما نتحدث عن العدالة الانتقالية في سوريا، يجب أن ننتبه إلى أن التجربة السورية تحتاج إلى مقاربة مرنة تُراعي تعقيدات الواقع، وثقل الذاكرة، وتشظّي المجتمع، وتَعدُّد روايات الضحايا. العدالة الانتقالية عملية تُصَاغ من الداخل وتنبع من السياق المحلي الثقافي والتاريخي والاجتماعي.
التجارب الدولية من أميركا اللاتينية إلى أفريقيا، ومن أوروبا الشرقية إلى العالم العربي، تُثبت أن الآليات التي لا تُكيَّفُ مع السياق المحلي تفشل في بناء الثقة والاستجابة لتطلعات الناس.
جنوب أفريقيا، مثلاً، لم تعتمد فقط على المحاسبة القضائية، بل ابتكرت «لجنة الحقيقة والمصالحة»، التي جمعت بين كشف الحقيقة وسماع الضحايا وتوفير فرصة للصفح المشروط مقابل الاعتراف بالجرائم. أما كولومبيا، فقد صاغت اتفاق سلام أدخلَ العدالة الانتقالية ضمن رؤية شاملة للحل السياسي مع حركة فارك، وتضمّنَ آليات تتناسب مع السياق الريفي المُعقَّد والمجتمعات المُهمَّشة.
في الحالة السورية، يجب أن تُبنَى الآليات على فهم عميق للبنية الاجتماعية، وانقسام الروايات، والخوف من العقاب الجماعي، وتدهور الثقة بالمؤسسات.
العدالة التي لا يُشارِك في صياغتها من تضرَّروا لن تكون إلا إعادة إنتاج للتهميش. يجب أن تبدأ العملية بمشاورات حقيقية مع الناجين والضحايا وأُسَرهم، من خلال آليات آمنة ومحترمة، تضمن لهم التعبير الحر عن مطالبهم وهواجسهم. ليس المقصود فقط الاستماع إليهم، بل إشراكهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المرتبطة بالعدالة.
في البيرو، أثبتت لجان الحقيقة والمصالحة أن جلسات الاستماع العلنية للضحايا لم تكن فقط وسيلة لجمع المعلومات، بل منصّة لبناء الاعتراف المجتمعي بمعاناتهم. التجربة نفسها يمكن أن تُلهِم سوريا، حيث إن الإنكار والتشكيك في بعض المجازر السورية ما زالا مُنتشرَين.
من الضروري أيضاً ضمان تمثيل الفئات التي عانت من الإقصاء المزدوج، مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي المعتقلين والمختفين، في المشاورات والحوارات الوطنية. ويجب أن يكون للشباب دور ريادي، فهم ليسوا فقط ضحايا، بل أيضاً صُنّاع تغيير محتملون. كثير من الشباب السوريين أداروا مبادرات مدنية محلية خلال النزاع، واستثمروا في التعليم الذاتي، وبنوا شبكات تضامن مجتمعية. لذلك لا يمكن تَصوّر عدالة انتقالية دونهم، بل إن إدماجهم في تصميم وتنفيذ برامج العدالة يضخّ الحيوية والمصداقية في العملية، ويُعيد الثقة بالمستقبل. في سيراليون، كان إشراك الشباب في لجان العدالة المجتمعية عاملاً أساسياً في تهدئة الصراعات ومَنعِ تجدد العنف.
أما الأطفال، فقد عانوا من النزاع ليس فقط كضحايا مباشرين، بل أيضاً من خلال فقدان التعليم، والتعرض للعنف، والنزوح. من الضروري دمج البرامج التربوية التي تركز على الذاكرة، وحقوق الإنسان، والتربية المدنية في المناهج التعليمية، وذلك لتعزيز وعي الجيل الجديد بتاريخ بلدهم وضرورة المُساءلة والمصالحة. تجربة رواندا في إدخال دروس حول الإبادة الجماعية والتسامح في التعليم كانت محورية في إعادة تشكيل وعي الأطفال وتحصينهم من الخطاب الانقسامي.
هؤلاء الذين لم يصنعوا الحرب، لكنهم وُلِدوا أو كبروا وسطها، هُم من سيتحمل مسؤولية بناء السلام غداً. إنَّ تمكينهم ليكونوا جزءاً من عملية العدالة الانتقالية ليس فقط من باب الإنصاف، بل من باب الاستثمار في مستقبل أكثر عدالة واستقراراً.
الشباب بحاجة إلى أدوات لفهم الماضي والتفاعل معه. وهذا يتطلب إشراكهم في أنشطة توثيق الذاكرة، والحوارات المجتمعية، والبرامج التعليمية التي تتناول تاريخ النزاع وأهمية المساءلة. أما الأطفال، فهم يحتاجون إلى نظام تعليمي جديد يزرع فيهم قيم العدالة والمساواة والتنوع، ويُحصّنهم من إعادة إنتاج الكراهية. يجب أن تكون المدارس مساحات لرواية قصص التعدد السوري، وأن تُدرَج في المناهج سرديات متنوعة تعكس الحقيقة كما عاشها مختلف السوريين، لا كما فُرِضَت عليهم.
لتحقيق كل ذلك، لا بد من استراتيجيات واضحة للمشاركة المجتمعية. الشفافية في طرح الأهداف، والوضوح في شرح المراحل، والاعتراف بالتحديات، هذه كلها عناصر تعزز الثقة بين الناس وعملية العدالة الانتقالية. التواصل ليس رفاهية، بل ضرورة لاحتواء القلق، وتبديد المخاوف، ومواجهة حملات التضليل.
لا بد أن تكون العدالة الانتقالية عملية يمتلكها المجتمع المحلي. «المُلكية المحلية» تعني أن تكون الأولوية لاحتياجات السكان، وأن تُبنى البرامج من الواقع وأولوياته، التي تتباين حسب كل منطقة، بحيث تنطلق من القواعد المجتمعية. سيكون الدعم الخارجي ضرورياً، لكنه يجب أن يأخذ طابع التيسير، والتوصيات والدعم والشراكة.
في تيمور الشرقية، أدى تكييف آليات العدالة الانتقالية مع الأعراف المحلية، مثل استخدام لجان المصالحة التقليدية (الـ«شيمبو»)، إلى تعزيز فعالية العملية وتوسيع نطاق قبولها المجتمعي. يمكن في سوريا استلهامُ مثل هذه المبادرات، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية، لكن بحيث أن لا تتعارض مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
المشروعية تبدأ من الشفافية والمشاركة
الشرعية ليست شعاراً يُرفَع، بل تُبنى عبر الممارسة والزمن من خلال ممارسات تُظهِرُ الاتساق والعدالة والشفافية. من هنا، لا بد من التواصل المستمر والصادق مع السوريين حول أهداف وآليات العدالة الانتقالية، مع الاعتراف بتحدياتها ومحدودياتها. يجب أن يشعر الناس أن هذه العملية تخصّهم، وأنها ليست امتداداً لصراعات النخب أو السلطات. أو الدول الفاعلة في سوريا.
إدارة التوقعات ضرورية أيضاً. لا يمكن أن تُحَلَّ جميع مشاكل سوريا من خلال العدالة الانتقالية. هي ليست عصا سحرية، لكنها أداة ضمن منظومة أوسع تشمل الإصلاح السياسي، والتنمية، وبناء الثقة المجتمعية. في جنوب أفريقيا، كان لشفافية لجنة الحقيقة والمصالحة، وتواصلها المباشر مع الناس، دور كبير في تجاوز النقد وتحقيق حدّ معقول من القبول.
في السياق السوري، يجب أن نرفض المقاربات التي تضع العدالة والمصالحة في تعارض دائم. فهُما ليستا نقيضين، بل يمكن أن تكونا متكاملتين. المصالحة الحقيقية لا تتحقق دون كشف الحقيقة، ولا معنى للعدالة إن لم تؤدِ إلى التئام الجراح وإنهاء العنف والمجازر.
التحدي هو بناء مساحات للحوار تسمح بهذا التوازن، وتمنع خطاب الانتقام، وتعزز مناخ الاعتراف المتبادل. قد يساعد استخدام الوساطة المجتمعية، والفن، وسرديات الضحايا، في فتح قنوات جديدة للتقارب بعيداً عن الاستقطاب السياسي التقليدي. العديد من المنظمات السورية عملت خلال السنوات الماضية على مشاريع للذاكرة الشفوية يمكن أن تُبنى عليها جسور لدرء الانقسامات السورية وكشف الحقيقة وسردها. كما تشكلت مؤخراً العديد من المبادرات المحلية التي تقودها نساء وعائلات الضحايا، مثل خيم الحقيقة وعائلات من أجل الحرية وسواها، والتي يمكن أن تكون مساحات للحوار والسرد والتضامن المجتمعي.
إذا أردنا لعدالتنا الانتقالية أن تُثمر، فلا بد أن نجعلها حواراً وطنياً شاملاً، لا مجرد سلسلة من الإجراءات القانونية. يجب أن تكون مساراً لبناء هوية سورية جديدة، تتسع للجميع، وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية كمبدأ لا يُساوَم عليه.
ربما تكون الطريق طويلة، لكن كل خطوة تبدأ من الاعتراف، ومن الشراكة الحقيقية، ومن الإرادة السياسية والمجتمعية لصنع التغيير. العدالة الانتقالية ليست فقط عن الماضي، بل عن مستقبل أفضل نستحقه جميعاً، ولا تتكرر فيه مجازر الماضي ولا تجاوزات الدولة ومؤسساتها.
لا معنى لعدالة تُفرَض من فوق، ولا مصداقية لآليات تُصمَّم في غرف مغلقة. يجب أن تشمل عملية التصميم مشاورات واسعة مع الضحايا من كل المناطق والانتماءات، وعائلات المفقودين والمعتقلين، والنساء اللواتي عانين من العنف الجنسي أو النزوح القسري، والمنظمات المحلية والنشطاء. دور النساء جوهري وقيادي في هذه العملية. في نيبال، تم تخصيص لجان نسائية محلية تساهم في توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا، وهناك العديد من التجارب النسائية المشابهة، والتي يمكن التعلُّم منها والبناء عليها في سوريا.
لبنان مثال على الإخفاق عندما تُغيِّبُ الدولةُ مشاورةَ الضحايا. فبعد الحرب الأهلية، اعتمدت السلطة «العفو العام» دون حوار مجتمعي، ما أدى إلى إنكار جماعي واستمرار جراح الماضي بلا معالجة. في المقابل، اعتمدت تونس مقاربة مختلفة من خلال «هيئة الحقيقة والكرامة»، التي نظّمت جلسات استماع علنية وأتاحت للمواطنين رواية معاناتهم. التجربة لم تكن مثالية، لكنّها فتحت المجال للنقاش العام وأعطت الضحايا موقعاً محورياً.
المشاركة المحلية تعني أن المجتمعات تشعر أنها شريكة لا ضحية فقط. وهو دور يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني السوري، والمجتمعات المحلية، والنساء، والشباب.
في سيراليون، تم تصميم المحاكم الخاصة بالشراكة مع المجتمع، مع التركيز على رمزية المكان وعلى إشراك الضحايا. أما في البوسنة، فالفشل في تمكين المجتمعات المحلية من صياغة العدالة أدى إلى ضعف تأثير محكمة لاهاي في المصالحة.
سوريا بلد تعددي. ولكي تكون العدالة جامعة، لا بد من إشراك مكونات المجتمع كافة. هذا التنوع إذا أُدير جيداً، يمكن أن يُشكّل مصدر قوة لا انقسام. ويجب أن تُصمَّم آليات العدالة بحيث تُمكَّن هذه الأصوات من التعبير عن تجاربها الخاصة.
كما أن غياب المعلومات والتواصل يغذي الشكوك والمخاوف. لذلك، من الضروري إعداد حملات تواصل مجتمعي لشرح أهداف العدالة، واستخدام اللغة التي يفهمها الناس، والانفتاح على وسائل الإعلام.
في كندا، أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة حول السكان الأصليين منصّة رقمية، وأنتجت محتوى مرئياً ومكتوباً، بلغات السكان الأصليين، ما ساهم في تعزيز الوعي والدعم الشعبي.
بناء التوافق وإدارة التوقعات
العدالة الانتقالية لا تَفرضُ السلم الاجتماعي فوراً، ولا تُرضي جميع الأطراف بالكامل. لذلك من الضروري أن نكون صريحين في تحديد ما هو ممكن الآن، وما الذي سيحتاج لسنوات. وكذلك الاعتراف بالتحديات والقيود، وشرح طبيعة الموازنة بين المحاسبة والحقيقة، والإصلاح والمصالحة. في غواتيمالا، أدى عدم وضوح الأهداف وتضارب الرسائل إلى فقدان الثقة في العملية، رغم انطلاقتها القوية. أما في ساحل العاج، فقد ساعدت المقاربة المرحلية، وربط العدالة بالإصلاح السياسي، على تعزيز الثقة تدريجياً.
في النهاية، إن مُلكية السوريين لهذه العملية لا تُقاس فقط بمن يُشارك في كتابة القوانين أو حضور الاجتماعات، بل بمن يشعر أن هذه العدالة تخصّه، وأنها تعنيه هو وأولاده ومستقبل قريته أو حيّه. لهذا، لا بد أن تُصمَّم العملية بشكل يستوعب التعدد السوري، ويُخاطب الناس بلغتهم، ويمنحهم أدوات فهم وتفاعل ومُساءلة.
بهذا فقط، يمكن للعدالة الانتقالية في سوريا أن تكون أكثر من مجرد مفهوم قانوني؛ أن تكون مساراً وطنياً نحو التعافي الجماعي والمصالحة المجتمعية، ينقل سوريا من زمن الألم إلى أفق جديد من الأمل.
في المقال الخامس والأخير، سنحاول أن نقدم تصوراً عملياً وخارطة طريق، نطرح فيها خمسة محاور رئيسية تُشكِّل معاً اللبنات الأساسية لبناء نموذج سوري منفتح وعملي للعدالة الانتقالية.
————————————
الجزء الخامس
رؤية ختامية لعدالة انتقالية سورية/ صطفى حايد
في الالتفات إلى الوراء (5)
09-05-2025
تنويه من الكاتب: تم استخدام صيغة المذكر لسهولة الكتابة والقراءة، لذا أود التأكيد على أن المحتوى يشير إلى التنوع الجندري والجنساني الذي تشمله التعابير المستخدمة في هذا المقال.
* * * * *
في المقالات السابقة، حاولنا أن نقترب خطوة بخطوة من سؤال العدالة في سوريا. استعرضنا المفهوم العام للعدالة الانتقالية، ثم تحدّثنا عن تحدياتها، وناقشنا بعض التجارب الدولية، وانتقلنا بعدها إلى مقاربة المشاركة المجتمعية والمُلكية المحلية.
في هذا المقال، وهو الخامس والأخير من سلسلة مكونة من خمسة أجزاء، نصلُ إلى المرحلة الأخيرة من تصوّر العدالة الانتقالية في سوريا ما بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024. مرحلة لا تقتصر على محاسبة الجناة أو تقديم تعويضات، بل تشكّل لحظة مؤسسة لسوريا جديدة، تقوم على الشفافية والعدالة والمشاركة والانفتاح. ولأن أي عملية عدالة انتقالية تحتاج إلى تصور عملي، نطرح هنا خمسة محاور رئيسية تشكّل معاً اللبنات الأساسية لبناء نموذج سوري، من شأنه أن يمهّد الطريق لشفاء المجتمع السوري، ويؤسس لدولة قانون ومواطنة متساوية للجميع. لتحقيق ذلك، ما الذي نحتاج إليه؟ ومن يجب أن يفعل ماذا؟
أولاً: قيادة سورية جامعة وشرعية
لكي تتمكن عملية العدالة الانتقالية من أن تتجذر وتؤتي ثمارها، فإنها تحتاج إلى قيادة سورية تمتلك الشرعية القانونية والأخلاقية والمجتمعية. هذه القيادة يجب أن تضم ممثلين عن ضحايا الانتهاكات، وممثلين عن المجتمع المدني، والأوساط القضائية، وناجين وناجيات من جميع المناطق. ويجب أن تكون منفتحة على كافة مكونات المجتمع السوري، وملتزمة بالمساءلة الفورية والجادة.
أما الحكومة الانتقالية، فعليها، وعلى الفور، أن تتخذ خطوات سريعة وحازمة لوقف الانتهاكات الجارية، وعلى رأسها المجازر والجرائم المتكررة في أنحاء متفرقة من البلاد، بما فيها وسط البلاد والساحل السوري، حيث ما تزال النزعات الانتقامية والتهديدات الطائفية قائمة. هذه الخطوات تتطلب إجراءات فعلية وشفافة، تطال مرتكبي الجرائم في جميع المناطق، بغض النظر عن انتماءاتهم. الصمت أو التباطؤ في هذا المجال سيعيد إنتاج العنف بشكلٍ مباشر، وسيقوّض أي جهود لتأسيس قيادة عملية شاملة وشرعية للعدالة الانتقالية.
يجب أن تضم قيادة العدالة الانتقالية قضاة وخبراء قانونيين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، وتمثيل حقيقي للنساء، والناجين، وعائلات الضحايا، وممثلي المجتمعات المحلية المختلفة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة. التعددية في القيادة ليست شكلاً ديمقراطياً فقط، بل شرطاً لتحقيق عدالة تنبع من وجدان الناس وتعبر عنهم وتمثل تنوعهم.
تجربة جنوب أفريقيا تقدم مثالاً ملهماً هنا. فمشاركة نيلسون مانديلا وديزموند توتو في تصميم قيادة لجنة الحقيقة والمصالحة أعطى للعملية شرعية أخلاقية وطمأنينة مجتمعية. أما في سيراليون، فإن إشراك النساء والضحايا في صياغة آليات العدالة ساهم في بناء ثقة مجتمعية أكبر في العدالة الانتقالية.
في لقاء دولي عن العدالة الانتقالية في سوريا، التأم في برلين في نيسان (أبريل) 2025، اعتبر بعض ممثلي المجتمع المدني السوري أن الحكومة السورية المؤقتة يجب أن تقود عملية العدالة الانتقالية. بينما اعتبر آخرون أن هذه العملية يجب أن تقودها هيئة مستقلة شاملة وممثلة لكل أطياف المجتمع السوري، وتتمتع بولاية قضائية وبآليات شفافية ومحاسبة. هذا الانقسام في التصورات والرؤى هو إثبات إضافي على ضرورة إجراء مشاورات وحوارات مجتمعية ووطنية من أجل التأسيس والتحضير لهذه العملية قبل البدء في تنفيذها.
ثانياً: خارطة طريق متدرجة وواضحة
من التجارب العالمية، كما في كولومبيا وجنوب أفريقيا وتونس، نعلم أن العدالة الانتقالية لا تحدُث دفعة واحدة، بل تحتاج إلى خارطة طريق متدرجة، تُبنى عبر التوافق المجتمعي والسياسي، وتراعي التحديات الأمنية والمعايير الدولية. يجب أن تشمل هذه الخارطة خطوات واضحة تبدأ بوقف الانتهاكات الحالية ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم التكرار، ثم الانتقال إلى عمليات كشف الحقيقة والمحاسبة والتعويض والإصلاح المؤسسي. هذه الخطوات لا تحتاج الى تراتبية، فالكثير منها يمكن أن ينفّذ بالتوازي إذا توفرت الموارد البشرية والمالية اللازمة، وكذلك الإرادة السياسية والمجتمعية.
أي خارطة طريق لا يمكن لها أن تنجح في بيئة يلفها الغموض وسوء التفاهم. لذلك نحن بحاجة إلى خارطة طريق واضحة، تتضمن إطاراً زمنياً واقعياً، ومعايير أداء محددة، وتوزيعاً شفافاً للأدوار والمسؤوليات. لا بد من تحديد ما الذي ستقوم به كل جهة، ومتى، وبأي أدوات، وكيف يمكن ضمان شفافيتها ومساءلتها.
التحدي الأكبر في العمليات الانتقالية هو إدارة التوقعات، فالناس تتوقع عدالة فورية، وجبر ضرر مباشر، وهو أمر غالباً ما لا يكون ممكناً بالسرعة المطلوبة. هنا تأتي أهمية التواصل الواضح مع السوريين، وإشراكهم في تحديد أولويات المرحلة، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المُحرز، والانفتاح الكامل على النقد والمساءلة. يجب إدراك أن العدالة لن تتحقق في يومٍ واحد، وأن الطريق سيكون طويلاً ومعقداً. لكن هذا لا يعني غياب الطمأنينة، بل يتطلب تواصلاً شفافاً، وتفسيراً مستمراً للأهداف والنتائج والخطوات القادمة. تجربة تونس تُظهر أهمية هذا الأمر. فقد وضعت هيئة الحقيقة والكرامة خارطة طريق واضحة تضمنت فترات لجمع الشهادات، وأخرى للتحقيق، وثالثة للمساءلة. صحيح أن التنفيذ كان متعثراً في بعض المحطات، لكنه شكّل مرجعية يمكن القياس عليها والمساءلة على أساسها.
يجب أن يكون الإطار الوطني للعدالة الانتقالية متاحاً ومفتوحاً للنقاش العام، يحدد المعايير الوطنية، وينسجم مع التزامات سوريا الدولية، ويستند إلى حقوق الضحايا لا إلى مصالح سياسية. في كولومبيا، أصدرت الحكومة خطة عمل مفصلة تضمنت مراحل العدالة، وتواريخها، وأدوات المتابعة، مما ساهم في خلق شعور عام بالثقة، رغم كل التحديات.
ثالثاً: صياغة نموذج سوري
النموذج السوري سيستفيد من تجارب الآخرين، لكن لا يجب أن يكون نسخة عنها، بل أن ينطلق من خصوصية الصراع السوري، التي جمعت بين الاستبداد والنزاع المسلح والانقسام المجتمعي والتدخلات الخارجية. هذا النموذج يجب أن يجمع بين السيادة والانفتاح الدولي، وأن يركز على:
كشف الحقيقة: ليس فقط عبر لجان رسمية، بل من خلال توثيق روايات الضحايا، وتاريخ المناطق، والذاكرة الجماعية والذاكرة الشفهية.
العدالة الترميمية: التي لا تكتفي بالعقاب، بل تسعى إلى تعويض الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع.
العدالة الجنائية: لمساءلة المسؤولين عن المجازر والجرائم الجسيمة.
الإصلاح المؤسسي: لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وبناء مؤسسات قضائية وأمنية خاضعة للمساءلة.
تصميم نموذج سوري للعدالة الانتقالية لا يعني الانغلاق على الذات، أو رفض الدعم الدولي بحجة السيادة، بل على العكس، نحن نحتاج إلى الخبرات والأدوات التي لا نمتلكها. نحتاج إلى الدعم في جمع الأدلة، وحماية الشهود، والتحليل الجنائي، وأرشفة الجرائم، وضمان عدالة تحترم المعايير الدولية. ولذلك، من الضروري أن نتواصل مع المؤسسات الدولية التي أُنشئت خصيصاً لدعم السوريين في هذا المجال، مثل:
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) لجمع الأدلة وحفظها.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) التابعة للأمم المتحدة.
المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا (IIMP)، التي تعمل على كشف مصير ومكان المفقودين، وتوفير الدعم الكافي للضحايا، بما في ذلك الناجين والناجيات وأسر المفقودين في سوريا.
الانفتاح والشراكة التي تستند إلى الوضوح والاحترام المتبادل ترسِل إشارة واضحة إلى الشعب السوري بأن العدالة ليست مجرد وعد داخلي، بل التزام دولي أيضاً. نحن بحاجة إلى الدعم الفني واللوجستي، وبحاجة إلى تطوير التعاون مع هذه الآليات، وسواها، التي أنشأها المجتمع الدولي من أجل سوريا.
رابعاً: أدوار الفاعلين: من يفعل ماذا؟
الحكومة الانتقالية:
يجب أن تضع العدالة الانتقالية في صلب أولوياتها، وأن تدعم وتُسهل المشاورات المجتمعية والحوارات الوطنية والدولية من أجل تأسيس هيئة مستقلة لقيادة هذا المسار، وكذلك توفير الدعم السياسي والتشريعي اللازم. تأسيس هذه الهيئة يجب ألا يكون احتكارياً وبمشاورات شكلية، وإنما بجدية وتشاركية وشفافية. يجب أن يكون أغلب أعضاء الهيئة من الناجين وعائلات الضحايا وممثلين من المجتمع المدني ومستقلين يتمتعون بالمصداقية والنزاهة، ودون أجندات أو ولاءات سياسية، وألا يقل تمثيل النساء فيها عن النصف. ويجب أن تكون عملية اختيار الأعضاء شفافة ويتم التعريف بأعضائها ومؤهلاتهم وأسباب اختيارهم. مع التركيز على حق السوريين في أن يعرفوا كيفية اتخاذ قرارات الاختيار والتعيين، ليكونوا قادرين على مساءلة الهيئة وأعضائها. ونعيد التأكيد هنا على أهمية إجراء مشاورات مكثفة وطنية ودولية عن الخيارات الأفضل لشكل هذه الهيئة وولايتها القضائية، وآلية تشكيلها والصلاحيات والموارد المالية، وكذلك الإطار الزمني لعملها. ومن المهم جداً أن تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية والحياد والشفافية.
السلطات الانتقالية، من جهتها، تتحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية، وضمان التنسيق بين الجهات القضائية، والمؤسسات المعنية بالتوثيق، وجبر الضرر، والمصالحة.
الناجون وعائلات الضحايا:
العدالة الانتقالية تبدأ من الضحايا، أو لا تبدأ أبداً. لكن ليس كـ«رمزيات» أو كـ«شهادات مؤثرة» فقط، بل كفاعلين رئيسيين في تصميم وتنفيذ ومراقبة العملية. الناجون يعرفون التفاصيل، ويملكون البوصلة الأخلاقية، ويدركون ما تعنيه المحاسبة وما تعنيه المصالحة القسرية. ينبغي أن يكونوا ممثَّلين في لجان التخطيط، وأن تكون لهم قدرة على وضع الفيتو الأخلاقي في وجه الصفقات السياسية التي تهدد كرامتهم. وفي ملف المفقودين والمختفين، لا أحد يمتلك الشرعية للمطالبة أكثر من أهاليهم، كما أثبتت «جمعية أمهات ساحة مايو» في الأرجنتين.
الضحايا يمكن أن يكونوا أيضاً جسوراً للتفاهم بين المجتمعات، إن تم تمكينهم ومنحهم المساحة. بعضهم فقد من الجانبين، البعض ينتمي لمناطق كانت في قلب الاستقطاب، وبعضهم حوّل ألمه إلى طاقة للتعليم والمصالحة. يجب حماية هذه الأصوات، وتمويلها، وفتح المساحات العامة لها، فهي الضمانة الأولى والأخيرة لعدالة لا تُختطف.
النساء:
غالباً ما تكون النساء أول من يتعرض للانتهاك وآخر من يُمنح الكلمة، وهذا ظلم مزدوج. فالنساء السوريات لم يكنَّ فقط ضحايا لعنف متعدد الأبعاد والأشكال، بل كنّ أيضاً عماداً لصمود العائلات والمجتمعات، وخط الدفاع الأول عن الحياة في زمن الفقد.
تمتلك النساء أدوات فريدة لفهم الظلم، لا من منظور الأرقام، بل من خلال التفاصيل المسكوت عنها: السجون التي لم توثق، الإذلال اليومي في نقاط التفتيش، الابتزاز الجنسي، الإفقار المنهجي، وانهيار الشبكات المجتمعية. فهم العدالة الانتقالية من منظور النساء يعني تضمين ما لا يُرى في الإحصاءات.
دور النساء لا يقتصر على الشهادات. بل عليهن أن يكنّ في موقع القيادة: كمصممات للعملية، ومنسقات لحوارات المصالحة المجتمعية، ووسيطات موثوقات في مناطق الانقسام. وهذا ليس تنظيراً، بل درساً مستفاداً من تجارب مثل ليبيريا، حيث قادت النساء عملية السلام، وكولومبيا، حيث لعبت الجمعيات النسائية دوراً محورياً في تشكيل لجان الحقيقة، وتونس، التي قدمت مثالاً مهماً حين ألزمت هيئة الحقيقة والكرامة بتمثيل نسائي حقيقي داخل لجانها، كما نظمت جلسات استماع خاصة حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
في سوريا، لا يمكن الحديث عن إعادة بناء البلاد أو تحقيق عدالة شاملة، دون الاعتراف الصريح بدور النساء وضمان مشاركتهن الحقيقية والتمثيل المتكافئ في كل مستوى من مستويات تنفيذ العدالة الانتقالية.
منظمات المجتمع المدني السوري:
لم يكن المجتمع المدني السوري طرفاً محايداً في الصراع ولا مجرد مراقب. كانت منظمات المجتمع المدني السورية أول من بادر إلى التوثيق، وجمع الشهادات، وأرشفة الأدلة، وإيصال الصوت السوري إلى المحافل الدولية. لقد حافظت هذه المنظمات، رغم الانقسامات والخلافات والتحديات الهائلة، على دورها كصمّام أمان أخلاقي ومهني. كثير منها شارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، وقدّم ملفات قانونية إلى آليات مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
عملت مئات المنظمات والمبادرات السورية على توثيق الانتهاكات الكبرى في سياقات مختلفة. هذا العمل التوثيقي شكّل العمود الفقري لأغلب الجهود الدولية القضائية، ومنها محاكمات كوبلنز في ألمانيا.
إلى جانب ذلك، يمثل المجتمع المدني جهة رقابة مستقلة على سير عمليات العدالة الانتقالية. يمكن أن يقيّم السياسات الحكومية، ويرصد تنفيذها، ويقترح البدائل عندما تغيب العدالة أو تنحرف عن مسارها. هو بمثابة جهاز «ضبط جودة» وطني.
يجب على هذه المنظمات أن تكون شريكة في تصميم وتنفيذ نموذج العدالة الانتقالية، لا كمزود خدمات أو صوت استشاري فقط، بل كفاعل أساسي وشرعي. وتستطيع هذه المنظمات، عبر شبكاتها المحلية، أن تيسّر الحوارات المجتمعية، وتشكّل جسور ثقة بين المجتمعات المختلفة، وتُسهم في إيصال أصوات المهمّشين.
تاريخياً، لعب المجتمع المدني هذا الدور في جنوب أفريقيا والأرجنتين والبوسنة. وكان لضغط منظمات الضحايا في البوسنة تأثيرٌ حاسم في توجيه عمل محكمة لاهاي وتوسيع اختصاصها. يمكن الاستفادة هنا من تجربة جنوب أفريقيا، حيث كانت منظمات المجتمع المدني شريكة في عملية تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة، وساهمت في تدريب الميسّرين وتجهيز جلسات الاستماع وتقديم الدعم النفسي للضحايا.
الإعلام المستقل:
لا تُبنى العدالة في الظلام. وأحد أخطر ما عاناه السوريون خلال السنوات الماضية، وحتى الآن، هو التشويش الإعلامي، والتضليل، وتزييف الوقائع. الإعلام المستقل هو القناة التي تنقل أصوات الضحايا، تفضح محاولات التلاعب، وتسلط الضوء على الانحرافات في مسارات العدالة الانتقالية. هو مرآة للرأي العام ووسيلة لخلق الوعي والضغط باتجاه المحاسبة.
في سيراليون، قامت وسائل الإعلام المحلية المستقلة بتغطية تفصيلية لأعمال لجان الحقيقة، مما ساعد في خلق نقاش مجتمعي واسع. وفي تونس، لعب الإعلام دوراً مهماً في كسر حاجز الخوف وجعل العدالة الانتقالية قضية رأي عام.
نعلم أن الإعلام السوري، لعقود، كان أداة بيد السلطة. ومنذ 2011، تحوّل إلى ساحة صراع أخرى، تغذّيها منصات حزبية وإيديولوجية. لكن وسط هذا الركام، نشأ إعلام مستقل، شجاع، رغم ضعف التمويل والموارد. لعب هذا الإعلام دوراً مهماً في توثيق المجازر، وكشف الانتهاكات، وأوصل الصوت المحلي إلى العالم.
في النموذج السوري للعدالة الانتقالية، يجب الاعتراف بهذا الإعلام كشريك، لا كمراقب فقط. لا بد من حماية استقلاليته، ودعمه، وتمكينه من أداء دور توثيقي وتحليلي ونقدي، خاصةً في مراحل الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة. وكذلك إعطاءه الحق في الوصول إلى كافة المعلومات. الإعلام المستقل يمكنه أن يكون منصةً للسرديات المختلفة، ومساحةً لعرض الشهادات، وحاملاً للذاكرة الجماعية.
تجربة سيراليون مثال مهم، حيث أُنشئت إذاعة وطنية للعدالة الانتقالية، تبث جلسات الاستماع، وتشرح أهداف العملية، وتجيب على أسئلة الناس. يمكن تبنّي تجربة مشابهة في سوريا، عبر إنشاء منصات صوتية ومرئية ترافق العملية من بدايتها حتى نهايتها.
في سوريا، نحتاج بشدة لدعم الإعلام المستقل، وخلق شراكات بينه وبين مؤسسات العدالة الانتقالية لضمان الشفافية، وفتح النقاشات الصعبة، وضمان ألا تتحول هذه العملية إلى صفقة مغلقة خلف أبواب السياسة.
الشباب والأطفال:
غالباً ما يُنظر إلى الشباب إما كضحايا أو كخطر. وفي الحالتين، يُقصون عن طاولة العدالة. لكن الحقيقة أن العدالة الانتقالية دون الشباب ليست سوى إعادة تموضع للماضي.
الشباب السوري اليوم، الذي نشأ خلال الحرب، عايش أشكالاً متعددة من الانهيار الأخلاقي والمؤسساتي. بعضهم حَمَل السلاح، وبعضهم أُجبر على الهجرة، وبعضهم يعيش صدمة لم تُسمع بعد. لكنهم أيضاً الأكثر قدرة على تجاوز الانقسامات، وخلق سرديات جديدة، وإعادة بناء الجسور بين المناطق والمجتمعات. ففي راوندا، أطلقت منظمات شبابية برامج لإعادة دمج المقاتلين السابقين من خلال الفن والرياضة والمشاريع المجتمعية. وفي جنوب أفريقيا، أسهم الشباب في توثيق الذاكرة ونقلها للأجيال التالية.
أما الأطفال، فيجب ألا ننسى أن الصراع كان حاضراً في حياتهم منذ المهد. العدالة الانتقالية يجب أن تشملهم: في المناهج التعليمية، والمساحات الآمنة للحوار، والبرامج النفسية، وفي روايتهم للتاريخ القادم. ليس كضحايا صامتين، بل كصُنّاع لذاكرة جديدة.
المجتمع الدولي:
لا يمكن للعدالة الانتقالية أن تنجح في بيئة معزولة. المجتمع الدولي له دور جوهري، ليس فقط في الدعم المالي والتقني، بل أيضاً في مرافقة العملية وتوفير ضمانات سياسية وأمنية. من الضروري أن يضع السوريون تصوراً واضحاً لدور هذه الجهات في كل مرحلة، بما يضمن المشاركة الأمثل والفعالة. يمكن للآليات الدولية أن تلعب أدواراً مهمة مثل:
تقديم الخبرة الفنية في جمع الأدلة وأرشفة الوثائق وتحليل البيانات.
تدريب الكوادر السورية على التوثيق الآمن والتحقيق الجنائي.
بناء قواعد بيانات مشتركة، ومواءمة الجهود مع المحاكم الوطنية لاحقاً.
دعم تأسيس أرشيف وطني للضحايا، كما فعلت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
تجربة كولومبيا في هذا السياق مفيدة، حيث لعبت الأمم المتحدة دوراً حاسماً في دعم لجنة الحقيقة، وتسهيل المفاوضات، وتقديم الضمانات للطرفين، مع احترام السيادة الكاملة للعملية.
خامساً: إعادة بناء النسيج المجتمعي
العدالة الانتقالية ليست فقط عن الماضي، بل هي أيضاً مشروع للمستقبل. نحتاج إلى بناء ذاكرة جماعية تعترف بكل الضحايا، وتُظهر الحقيقة كاملة، وتمنع الإنكار. لكن كيف نفعل ذلك في بلدٍ مثقل بالانقسامات؟
الجواب يبدأ بالتربية والمناهج. يجب أن تعاد صياغة الكتب المدرسية لتعكس سرديات متعددة، وتُعلّم قيم التسامح، وحقوق الإنسان، والمساءلة. كما ينبغي إشراك الأطفال والشباب في ورشات عمل، وأفلام وثائقية، ومسرحيات مدرسية تُعزز الذاكرة الوطنية دون كراهية.
في رواندا، لعبت المناهج التعليمية دوراً كبيراً في تجاوز خطاب الكراهية، حيث تم إدراج مواد حول الإبادة الجماعية وأثرها، إلى جانب برامج إذاعية ومشاريع شبابية عززت الحوار بين الناجين وأبناء الجناة. وفي سيراليون، أنشئت لجان طلابية شاركت في بناء أرشيف صوتي لذاكرة الحرب. لذلك يجب تضمين مواضيع العدالة، والحقوق، والتنوع، والتاريخ النقدي في المناهج المدرسية، عبر سردية متعددة الأصوات، لا تستثني أحداً. ويجب إشراك الأطفال والشباب، ليس فقط كمستفيدين، بل كفاعلين ومساهمين في إعادة تخيل سوريا.
أيضاً، ينبغي دعم مبادرات المصالحة المجتمعية الصغيرة التي تُبنى من القاعدة، مثل الدوائر المجتمعية، والمصالحة على مستوى الأحياء، ومراكز الدعم النفسي للناجين. هذه المبادرات تصنع فرقاً حقيقياً على الأرض، وتساعد في ترميم العلاقات الاجتماعية من الأسفل إلى الأعلى.
العدالة الانتقالية يجب أن تؤسس لسوريا موحدة، خالية من الكراهية، تقوم على التعدد والانفتاح والكرامة الإنسانية. ولكي يتحقق ذلك، علينا أن نزيل كل أسباب تكرار الجرائم والانتهاكات، بدءاً من خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وانتهاءً بالتمييز المؤسسي وغياب المحاسبة. علينا تفكيك كل مراحل الإبادة والعنف المنظم، من التنميط، إلى نزع الإنسانية، إلى الإفلات من العقاب. وهذا لا يتم إلا من خلال منظومة عدالة مستقلة، وقضاء مهني، وأجهزة أمنية خاضعة للمساءلة وللرقابة البرلمانية والقضائية. نحتاج إلى قضاء مستقل، محترف، غير مسيّس، يستطيع أن يحمي الحقوق ويحاسب المعتدين.
العدالة الانتقالية كضرورة تاريخية وأخلاقية، هي الوحيدة القادرة على أن تفتح الطريق نحو سلام عادل، ومجتمع متصالِح، ودولة حامية للحقوق، لا قاهرة لها. إنها دعوة لكل سوري وسورية، بأن نكون مستعدّين للانفتاح على بعضنا البعض، والانفتاح على العالم، والتفكير معاً في كيف نعيد بناء بلدنا، بكرامة، وبمسؤولية مشتركة.
موقع الجمهورية
——————————-
خطوات مهمّة لكنّها منقوصة/ حسان الأسود
22 مايو 2025
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، السبت الماضي (17 مايو/ أيار الحالي) مرسومَين، يقضيان بإحداث هيئتَين وطنيتَين للمفقودين وللعدالة الانتقالية. هذان الملفّان هما رئيسان في مجموعة التحدّيات الكبرى التي تواجه سورية دولة ومجتمعاً، حاضراً ومستقبلاً. استُقبل مرسوم المفقودين بترحابٍ كبير، بينما تعرّض مرسوم العدالة الانتقالية لانتقاد شديد.
تنتظر غالبيةٌ وازنةٌ من الشعب السوري تشكيل آليات حقيقية وفعّالة فيما يخصّ ملفّ المفقودين والمختفين قسرياً، وهذا الملفّ يشمل بطبيعة الحال المعتقلين الذين لم يظهر لهم أثر في السجون بعد سقوط النظام، كما يشمل المقابر الجماعيّة التي لم يُكشَف منها إلا النذر اليسير حتى اللحظة الراهنة. كذلك، فإنّ مجموعة أكبر من الشعب السوري، بل حتى من شعوب مجاورة، تنتظر بفارغ الصبر إطلاق مسارٍ متكامل للعدالة الانتقالية، لأنّ ذلك مرتبط بملفّاتٍ كثيرة تخصّهم أو تخصّ ذويهم، أو تنعكس بشكل مباشر في الاستقرار الأمني في البلد، وبالتالي تؤثّر (بشكل لاحق وغير مباشر) في الاستثمار الذي ينتظره الجميع ويتطلّعون إليه بلهفة. تنظر هذه الفئات المُرحِّبة إلى النصف الممتلئ من الكأس، ففي أذهان أفرادها وجماعاتها تحضر دوماً المقارنة بنظام الأسد، وفي قلوبهم تحضر دوماً فرحة الخلاص منه وهزيمته مع حلفائه وأتباعه وشياطينه. ما تحصّلت عليه هذه الفئة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما يزال أشبه بالحلم، تخشى أن تخسره إن فتحت أعينها أو إن أغلقتها.
سيمضي وقت طويلٌ قبل أن تنسى هذه الفئة الوازنة من الشعب نصرها العظيم هذا. هذه الفئة نفسها ذاقت (بغالبيتها) الأمرَّين من شرور الأسد ونظامه، وهي لن تترك الحلم يفلت من بين أصابعها، لأنّه ببساطة أصبح واقعاً جديداً، وأوجد لها أفقاً واسعاً وفتح أمامها أبواب الأمل بمستقبل أفضل. من ناحية ثانية، لا بدّ من قراءة نقدية للهيئتين المذكورتَين، تنطلق من التأصيل الدستوري والقانوني لهما، مروراً بآليات التشكيل والاختصاص، ومنهجيات العمل والنتائج المرجوّة. من دون هذه القراءة سنبقى ضمن دائرة الوصف الأيديولوجي، مع أو ضد، من دون تبيان الأسباب التي دفعتنا إلى هذا الموقف أو ذاك بشكل قابل للقياس.
يرى عديدون أنّ ملفّي المفقودين والعدالة الانتقالية كليهما، جزء من منظومة متكاملة لا فكاك بين عناصرها، فمن دون نظام دستوري أعلى، ومن دون نظام قانوني سائد وبيئةٍ حقوقيةٍ مساعدة، لا يمكن الوصول إلى نتائج مُرضية فيهما كليهما. هذا يقتضي بالضرورة أن يكون هناك تعاون كبير وتنسيق دائم بين وزارات متعدّدة، أهمها العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. إضافة إلى ذلك، لا بدّ من توفر بيئة مساعدة للنجاح في كلا الملفَّين، منها الدعم المالي اللازم لاستقطاب الكفاءات من المحقّقين والمتخصّصين في مجالات التحليل الجنائي والطبّ الشرعي والخبراء القانونيين والمرشدين النفسيين والقضاة والمحامين وغيرهم كثير. لا بدّ أيضاً من توافر بيئة بيروقراطية مرنة لتنظيم العمل وتسهيله في الوقت ذاته. هذه القضايا كلّها تحدّيات لا يُستهان بها ستواجه الهيئتَين والقائمين عليهما.
بالعودة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/ آذار 2025، نجد أنّه منح رئيس الجمهورية (المادّة 36) الحقّ بإصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقاً للقوانين. كما أعطاه (المادة 39) الحقّ باقتراح القوانين، وسلطة إصدار القوانين التي يقرّها مجلس الشعب. وبمفهوم المخالفة المعمول به في الحقول الدستورية والقانونية، نستنتج أنّ الرئيس لا يملك إصدار المراسيم، لأنّ النصّ واضحٌ بعدم إدراجها ضمن صلاحياته. هذا يعني من حيث المبدأ وجود عَوارٍ دستوري متمثّل بالسلطة التي أنشأت الهيئتَين المذكورتَين، أي أنّ الهيئتَين جرى إنشاؤهما من سلطة غير متخصّصة مبدئياً، وبأداة لا تملكها هذه السلطة أساساً، بمخالفة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس ذاته.
يرى كاتب هذه السطور أنّ هيئتَين بهذا الحجم وبهذه المهام، وبالثقل كلّه الذي تحملانه، وجب أن تُشكَّلا من برلمانٍ منتخب أو معيّنٍ وفق الآلية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري على الأقلّ. يكون القانون ثمرةَ نقاشات مستفيضة ويستند بالضرورة إلى توازنات تأخذ بالاعتبار التعدّدية التي يمثّلها البرلمان ذاته. ومن جهة ثانية، لا بدّ أن تُحدّد في صكّ الإنشاء، الذي نعتقد أنّه كان يجب أن يكون، قانوناً لا مرسوماً رئاسياً، مجموعةً من الاعتبارات الواردة في الإعلان الدستوري نفسه الذي نصّ في مادته 49 على: “تُحدّث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحقّ في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء. وهذه الاعتبارات لم تُؤخذ بالاعتبار في المرسوم رقم 20 الذي نصّ على: “تُشكَّل هيئة مستقلة باسم (الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)، تُعنَى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية… يُعيَّن السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، ويُكلَّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان”. فأين الآليات الفاعلة التشاورية المرتكزة على الضحايا؟ وما المعايير التي سيعتمدها رئيس الهيئة في تشكيلها واختيار أعضائها؟ وما القواعد التي سيتمّ الاستناد إليها عند وضع نظامها الداخلي؟ وهل تكفي مهلة 30 يوماً لهذا؟… الحقيقة أنّ حصر هذا الأمر في فرد، أو في مجموعة أفراد، مهما بلغت درجة معرفتهم أو مهما كانت قدراتهم والثقة التي يحوزونها لدى الرئيس، سيؤدّي إلى التفريط بقضيّة جوهرية وحسّاسة جدّاً هي المشروعية التي يضفيها اشتراك ممثّلي الشعب كلّه في هذا الإنشاء أو التأسيس.
من المثالب الكبرى التي تؤخذ على هيئة العدالة الانتقالية أنّها حصرت اختصاصها بـ”كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبّب فيها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها”، وهذا الأمر، وإن كان متوافقاً مع ما ورد في الإعلان الدستوري، إلا أنّه لا يتوافق مع طبيعة العدالة الانتقالية ذاتها. استوقف هذا الأمر كثيرين من الحقوقيين والحقوقيات السوريين والسوريات، والمنظّمات الحقوقية المحلّية والدولية، فقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ “الصلاحية المحدودة لهيئة العدالة الانتقالية تقوّض مصداقيتها وتقصي العديد من الضحايا، وأنّ الفظائع الأخيرة وتصاعد الخطاب الطائفي يؤكّدان على الحاجة المُلحّة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة، عملية لجميع السوريين، وليس لبعضهم فقط، وأنّ الحكومة السورية أمام مفترق طرق، فإما أن تتبنّى عملية حقيقية تُركّز في الضحايا وتُقرّ بحقوق جميع الناجين، أو تُديم الإقصاء وتُعمّق الانقسامات”.
ما ذكرناه عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ينطبق بدرجة أقلّ على الهيئة الوطنية للمفقودين، خاصّة من ناحية السلطة صاحبة الحقّ في الإنشاء وآليات العمل. ونخلص من هذا كلّه إلى أنّه رغم الفرحة الكبيرة التي استقبل بها الضحايا وأهالي المفقودين إنشاء هاتَين الهيئتَين، إلّا أنه كان بالإمكان التريّث بذلك وإعطاء الأمر حقّه الطبيعي الذي يستحقّه، وفق ما ناقشناه أعلاه. ويبقى أن نلتمس العذر للإدارة الجديدة من نافذة حجم التحدّيات الكبيرة التي تواجهها، ومن باب حجم المهامّ الهائلة الملقاة على عاتقها، لكنّنا ننصحها أيضاً بتوسيع دائرة المشاركة، حتى تنهض بما أنيط بها وتنهض البلاد معها.
العربي الجديدة
———————————–
العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات/ محمد العبدالله
في إطار التعليق والأخذ والرد حول إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تكرر طرح أن أي سلطة في العالم لن تحاكم نفسها أو مقاتليها. وهذا صحيح. ما حدا متوقع هيك شي. لكن فكرة ومفهوم العدالة الإنتقالية ليس فقط المحاكمات. وهنا حل المشكلة أساساً.
العدالة الانتقالية كمفهوم كثير بسيط: مساعدة المجتمعات أن تتجاوز مراحل من الإنتهاكات الجسيمة والقمع المنظم يلي تعرضت له. تركيزها الأساسي على الضحايا ومصالح الضحايا.
بعض الأطر الفكرية لمفهوم العدالة الإنتقالية، تطرح عدة برامج معقدة ومترابطة فيما بينها:
1- المحاكمات الجزائية: محاكمة مسؤولين سابقين ومحاكمة عناصر أمن ومليشيات، ومحاكمة أمراء حرب أيضاً. الملف جداً معقد وممكن يتراوح من محاكمة بضعة آلاف إلى محاكمة فقط كبار الضباط… إلخ.
2- لجان الحقيقة: وهي ما دخلها بالمصالحة ولا العفو. في كثير دول سابقاً شكلت لجان الحقيقة والمصالحة وفي ترابط بينها، لكن هذا ليس ضروري. هي اللجان شغلتها تجمع سردية الضحايا والمجتمع وتحاول تأسس لفترة من تاريخ الصراعات والإنتهاكات وتقول الحقيقة عما حصل (بخصوص السجون، التعذيب، البراميل المتفجرة، الكيماوي، الفساد… إلخ). هي مرتبطة أكثر بالذاكرة الجمعية للبلاد.
3- كشف مصير المفقودين: في حال كانت البلد، كحال سوريا، فيها اعتقالات وفيها مفقودين، ممكن إطلاق برنامج وطني لكشف مصير المفقودين. هذا بكون متعاون مع الجسم القضائي بالتحقيقات، وفيه خبرات من محققين جنائيين وصولاً لخبراء طب شرعي أنثربولوجي في حال تطلب الوضع فتح المقابر الجماعية مثل سوريا (أو غواتيمالا أو راوندا أو كمبوديا). وطبعاً حصل إنشاء آلية منفصلة للكشف عن مصير المفقودين يوم أمس أيضاً.
4- إصلاح المؤسسات عموماً: ليس فقط المؤسسة القضائية والشرطة والأمن، لكن كل المؤسسات. في عملية تعرف عادة باسم “الغربلة والتطهير”. أنك تأسس معايير مين بضل بوظيفته السابقة ومين بروح على البيت. هدول مو مجرمين ولا بيتحاكموا لكن في فساد وفي سوء استخدام للسلطة وغيره. طبعاً إصلاح المؤسسة الأمنية من أصعب وأعقد الملفات.
5- برنامج لعودة المهجرين واسترداد الممتلكات العقارية: في حال حصل تهجير قسري، ممكن إنشاء مثل هي البرامح يلي بتساعد أصحاب الحق على العودة إلى مناطق سكنهم واسترداد حقوقهم بالملكيات وغيرها. هذا الملف لا يقل تعقيداً عن أي ملف آخر (حدا اشترى عقار بحسن نية ورجع صاحبه الأصلي قاله أنا كنت مهجر مثلاً).
6- جبر ضرر الضحايا: برنامج وطني للتعويضات. تعويض أهالي المفقودين في حال كان رب الاسرة هو المفقود. تعويض مصابي الحرب ممكن خرجوا باعاقات دائمة للأسف، وتعويض ضحايا التعذيب. هون التعويض ليس مادي بالضرورة. ممكن رعاية طبية مجانية مدى الحياة، أو فرض نسبة من الوظائف لضحايا الحرب وغيرها من الأفكار.
7- تخليد ذكرى الضحايا: يوم حداد وطني. أو يوم وطني للمفقودين. متحف وطني للذاكرة. عادة إبقاء هي التفاصيل حية وكشفها للناس يساعد بعدم تكرار الإنتهاكات.
في كثير أفكار، معقدة جداً ومتداخلة. بعضها مرتبط ببعضه إرتباط وثيق. مثلاً لما تحاكم ضابط سابق لازم تستجوبه عن مصير المعتقلين. وإذا قدم معلومات تكشف مواقع احتجاز أو مقابر جماعية، ممكن تساعده بتخفيف الحكم مشان يصير في حافز للمتهمين بالتعاون.
في ترابط وثيق بين كل هذه الملفات. وواضح أن مرسوم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية يذكر معظمها:
1- كشف الحقيقة.
2- مساءلة ومحاسبة المسؤولين (وهو الملف الشائك الذي أثار كل النقاش)
3- جبر الضرر الواقع على الضحايا
4- ترسيخ مبادئ عدم التكرار
5- المصالحة الوطنية.
ممكن ببساطة العمل على معظم هذه النقاط لجميع الضحايا في سوريا. نقطة المساءلة هي المستحيلة هنا وتتطلب عمل منفصل وتطور ببعض باقي الملفات على الأقل.
رأي بعض الأصدقاء أن إنشاء الهيئة أمر إيجابي وخطوة أولى.
صحيح هي خطوة أولى فقط، لكن الخوف أن مرسوم إنشاء الهيئة يمنعها قانونياً من العمل على هذه الملفات إلا لضحايا النظام. مع العلم أن هناك آلاف الأسر مثلاً اعتقل تنظيم داعش أبنائها أو أعدمهم، عشيرة الشيعطات وحدها دفعت آلاف الشهداء في معارك مع التنظيم، مروراً بباقي الأطراف إلى دول شاركت بالدم السوري.
توسيع عمل هيئة العدالة الانتقالية من البداية ليست فقط أمر مهم لثقة الناس ومصداقية الهيئة وعملها في المستقبل، لكن أيضاً ضروري للهيئة ذاتها قبل أن تبدأ تعيين كوادرها. يعني مثلاً بدك شخص يعرف تنظيم داعش وتاريخه وهيكليته وجرائمه كمحلل ضمن الفريق. اذا ما وسعت عمل الهيئة من البداية ستكشل فريق خبير فقط بانتهاكات طرف واحد… وهكذا.
يعني ليس المطلوب أمر تعجيزي ولا مستحيل ولا خيالي حتى يتم وصفه بمطالب أفلاطونية. ممكن العمل بموضوعية وصدق على الكثير من الملفات والتقدم بها بحسن نية يقدم الخير لجميع الضحايا ويجبر خاطرهم
————————————-
إقرار مرسوم العدالة الانتقالية في سوريا ومخاوف من تحوله أداة انتقامية/ طارق علي
علامات استفهام كبيرة تُرسم على مدى نجاعة الهيئة المستحدثة ومدى شمولية عملها
الجمعة 23 مايو 2025
ترى شريحة كبرى من السوريين بعد تشكيل “هيئة العدالة الانتقالية” أن تلك الهيئة ستراعي منطق عدالة ما قبل إسقاط نظام بشار، ومن ثم ستتغاضى عما حصل بعده من قتل وخطف لم يتوقف.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع أخيراً مرسوماً بتشكيل “هيئة العدالة الانتقالية” على أن تكون مهمتها كشف الحقائق في شأن انتهاكات النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاته مع جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية، كذلك تتمتع تلك الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المادية والمعنوية.
المرسوم فتح الباب عريضاً أمام التساؤل حول محاسبة “داعش” و”النصرة” وبقية الفصائل المعارضة التي أوغلت في الدم السوري عبر القنص والقتل وهجمات الانتحاريين والمفخخات التي أفضت إلى مقتل عشرات آلاف السوريين خلال أعوام الحرب الطويلة، كذلك فإنها تراعي فقط منطق عدالة ما قبل انتصار الثورة وتغض النظر عن مقتل آلاف المدنيين ما بعد انتصار الثورة على يد فصائلها، على ما يقوله سوريون.
مفهوم معقد
لا شك أن قرار الشرع يفتح المسار أمام معادلة سياسية واجتماعية جديدة في سوريا، ويمكن النظر إلى ذلك القرار من زاوية المفهوم الدولي على أنه أحد أبرز سمات الركائز المتينة نحو طريق السلام والاستقرار في مرحلة ما بعد الديكتاتورية المباشرة التي استمرت عقوداً، لكن الحال في سوريا الممزقة يختلف في هذا السياق، فالعدالة الانتقالية لا تعني المحاسبة فقط، بل تشمل المحاكمات، ومنح العفو حين يلزم، مما يضع مسار الهيئة أمام تحديات صعبة، ليس على صعيد ارتكابات النظام السابق من جرائم ومجازر دموية وحسب، بل لشكل سوريا نفسها ما بعد الثورة وانعدام تجانس المكونات التي أفضت إلى ارتكاب فصائل المعارضة التي وصلت إلى الحكم، مجازر وانتهاكات جديدة، فعلى أي زمن ستُحسب تلك التجاوزات والمرسوم واضح في أي اتجاه سيحاسب؟
المشكلة التي تراها شريحة كبرى من السوريين اليوم، والتي عبروا عنها في أحاديثهم وتدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن تلك الهيئة ستراعي منطق عدالة ما قبل إسقاط نظام بشار، ومن ثم ستتغاضى عما حصل بعده من قتل وخطف لم يتوقف، ومن قضية الساحل في مارس (آذار) الماضي التي لا يزال صداها يتردد داخلياً وخارجياً إثر مقتل نحو 2000 مدني أعزل على أيدي جماعات أُثبت انتماؤها إلى الجهات الرسمية في غالب الأحيان، وعليه، يخشى أولئك الضحايا أن تتحول العدالة الانتقالية إلى أداة انتقامية نافذة فتعمّق معها الخلاف والانقسام والأحقاد عوضاً عن أن تكون أداة جامعة في مسار الصلح الأهلي والمجتمعي.
أستاذ القانون الدولي السابق في جامعة دمشق عبدالله سامح يقول لـ”اندبندنت عربية” إن “مفهوم العدالة الانتقالية معقد ومحفوف بالألغام والأخطار التي يجب تجاوزها للتمكن من بناء مجتمع قوي ورصين لا تستقوي فيه فئة على أخرى، ولا يغفل جرائم طرف على حساب طرف آخر، فالعدالة يجب أن تكون نزيهة وشفافة وموضوعية وغير منحازة وإلا فإنها ستعيد إنتاج مظلوميات بالجملة”.
يحضر هنا في هذا الإطار رأي سارة سلامة الأكاديمية في علوم اللغات إذ تساءلت عن محاسبة قاتلي أخيها الذي قضى عام 2015 بقصف نفذته فصائل المعارضة من غوطة دمشق على حي باب توما في العاصمة السورية بقذائف الهاون، وتقول “لسنا ضد العدالة، ولكن أن تكون عدالة فعلية تحاسب كل من أجرم في حق الشعب السوري، الذي لم يكن يميز النظام والمعارضة بين الضحايا حين يقصفون الأحياء السكنية”.
الثورة تمحو ما قبلها
على رغم الاستقرار الأمني النسبي في سوريا طوال عقود ما قبل الحرب، فإن ذلك لم يكن كافياً لدرء انفجار ثورة قامت على مظلوميات اجتماعية وإقصائية طويلة، ومع الثورة وتداخل القوى وصراع النفوذ والسيطرة صارت سوريا ساحة للقتل وآلة حاسبة لتعداد أرقام القتلى يومياً من كل الأطراف، وما تلا ذلك من خطف وتغييب قسري وانتهاكات جسدية ومعنوية وترهيب مستمر. وفي خضم ذلك استخدمت أطراف الصراع مختلف صور القصف على المدن والبلدات والحواضر، وكان المدني دائماً حاضراً على رأس سجلات القتلى، وعلى رغم أن النظام فاق بوحشيته سواه، حين قصف أعداءه بالأسلحة المحرمة دولياً كالكيماوي والسارين والصواريخ المركزة وغيرها، فإن “داعش” لم يقل بوحشيته في عز قوته عن النظام، ولم تكن “النصرة” بمنأى عن تبني عشرات التفجيرات والانتحاريين ومئات المعارك.
يطرح الحائز على دبلوم العلاقات الدبلوماسية، منير صبرة، تساؤلات حول “ما إذا كان تم توافق سلطوي ضمني على أن انتصار الثورة يمحو ما قبلها، ولكن ماذا عما حصل بعدها من أحداث دموية عصفت بحمص وحماة والساحل ودرعا ودمشق وغيرها”، ويقول، “نحن اليوم أمام حالة تعامٍ مقصودة عن انتهاكات موصوفة وموثّقة لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، هذه الحال ستزيد من معاناة عشرات الآلاف الجدد الذين انضموا إلى قائمة الضحايا، وإلا لماذا لا يزال لدينا 30 ألف هارب إلى لبنان من الساحل و10 آلاف محتمون في مطار حميميم، ممَّ يخافون لو كان هناك مسار عدالة حقيقي؟”.
بدورها ترى الحقوقية ميرنا عمران أن “المرسوم يقسّم السوريين إلى نخبة أولى وثانية، فتجاهل طرف على حساب طرف آخر قد يعيد إنتاج فوضى دموية نابعة من شعور طرف بفرط القوة وذلك أكبر إسفين ممكن أن يوضع في جسد بناء مستقبل مشترك لجميع السوريين”.
وفي إطار مضاد يرى الشاب محمد محمد وهو معتقل سابق أن “ما اقترفه نظام الأسد من جرائم وانتهاكات وسجون لم يسبقه إليه أحد”، وأن “الإجرام يبدأ وينتهي عند ماكينة الأسد العسكرية والأمنية”، معتبراً أن “الفصائل المعارضة دائماً كانت في حال دفاع عن النفس، حتى في حال أحداث الساحل فهي كانت تواجه فلول نظام مخلوع. الحرب مع ’داعش‘ لم تنته فهي خارج تصنيف تطبيق مفهوم العدالة، أما النصرة التي صارت هيئة تحرير الشام وحررت سوريا ومعها بقية الفصائل، فهؤلاء ثوار كانوا يردون الأذى عنهم وعن أهلهم”.
العدالة الانتقالية والثورة
حجر الأساس
يرى حقوقيون ومتخصصون في الشؤون القانونية أن هيئة العدالة في الحال السورية تتخطى كونها ملفاً قانونياً وسياسياً بحتاً، بل هي حجر الأساس في بناء المجتمع ونزع فتيل التوتر من بين أفراده، وعليه يؤكدون أنها لا يجب أن تناصر طرفاً على آخر فتقوض معها جهود المصالحة وتعزز حالات الثأر والانتقام خارج أروقة المحاكم.
“عام 2011 اختُطف أخواي الاثنان في حمص وقُتلا لاحقاً، وقتها لم يكن هناك فصائل متشددة، كانت معارضة مسلحة تقليدية”، يقول المهندس جابر معروف ابن مدينة حمص، متسائلاً عن قتلة أخويه وعن جدوى المرسوم الذي لن يحاسبهم بعد مضي 14 عاماً على فقدانهما، ويضيف، “هل من شخص حمل السلاح ولم يتورط بالقتل؟ نعم قد يكون بعض المسلحين ركز على مواجهات عسكرية مباشرة على الجبهة، لكن ماذا عن خطف آلاف المدنيين والتنكيل بهم وقصف المدن ليل نهار بالقذائف؟ وبالمناسبة أنا هنا لا أعفي الأسد، فقد كان يبرع بتلك الممارسات، أنا فقط مهتم بأن تبحث هيئة العدالة عن قاتلي أهلي وأخويّ”.
شروط النجاح
يرى القاضي المتقاعد رؤوف الجندي أن “العملية المرتبطة بالعدالة الانتقالية يجب أن تتسم بأساسات لا يمكن تجاوزها، وعلى رأسها وجود آليات قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والسيادة والشفافية والاستقلالية التامة مع صلاحيات مطلقة ومفتوحة تشمل كل أراضي الجمهورية العربية السورية لتبحث في الانتهاكات التي وقعت خلال أعوام الحرب في مختلف المواقع، فمدن شرقية مثل دير الزور لم تقل معاناتها عن مدن أخرى شهدت حروباً ضروساً، كذلك فإن أطرافاً أخرى لها انتهاكاتها، كقوات ’قسد‘ الكردية التي لا يمكن تطبيق عمل اللجنة عليها لانفصالها عضوياً عن حكومة دمشق المركزية”.
ويؤكد القاضي خلال حديثه مع “اندبندنت عربية” أن “اللجان التي ستنبثق عن الهيئة تلك ستحتاج إلى دعم مركزي منقطع النظير مع دعم إقليمي واستشارات دولية عبر الفرق المتخصصة في مجالات القوانين الدولية والإنسانية”، مؤكداً أن “إشراك أطراف خارجية في التحقيقات سيضمن نزاهتها، وما يمكن أن يزيد من نزاهة تلك اللجان مجتمعةً هو أن يكون المجتمع الأهلي شريكاً من دون إقصاء لمكون أو طرف على حساب آخر”، ويضيف أن “عمل اللجنة لا يجب أن يقتصر على مرتكبي جرائم الحرب، بل يجب أن يتعداه نحو أدوار أكثر خصوصية كمثل إزالة ثقافة الانتقام والثأر وتعويضها بالتسامح الجمعي، ويمكن أن يكون ذلك عبر الإرشاد والتوعية انطلاقاً من المدارس والمعاهد الشرعية والجامعات والمنابر الدينية والمنتديات الثقافية والإعلام”.
صراع المظلوميات
في آراء مقابلة، يرى آخرون أن الأسد هو من فجّر الصراع، وهو من استقوى بميليشيات الداخل والقوى الخارجية، فولّد لدى الطرف الآخر ردود فعل عنيفة، فيما يُواجه هذا الرأي بأن الأمر كان كذلك فعلياً ولكنه لا يمكن أن يبرر بأية صورة حوادث المفخخات والانتحاريين والمتشددين الذين صاروا ركيزة في قتاله ضمن ساحة عالمية تمتص الأفكار المتشددة، ويستذكر البعض أن حمص وحدها تعرضت لانفجار أكثر من 90 سيارة مفخخة في الفترة ما بين عامي 2012 و2017، عدا عن مفخخات المدن الأخرى، والأحداث المؤلمة والقتل العشوائي والقصف على الأحياء المدنية، وما بين كل ذلك من اقتتال فصائل المعارضة في ما بينها، فهل ستشمل العدالة الانتقالية البحث في ذلك الملف أيضاً؟ يبدو الأمر مستبعداً للغاية.
الآن يرى سوريون كثر أنهم تعرضوا لمظلمة كبرى بعيد انتصار الثورة، ويقابلهم سوريون بمظلمة أكبر قبل انتصارها، وما بين المظلمتين لا يمكن أن تستوي العدالة بمحاسبة طرف دون آخر، خصوصاً مع اتهامات بتمييع عمل لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها السلطة للبحث في أحداث مجازر الساحل، وها قد مضى شهران من دون نتيجة، فهل سيقبل رفاق سلاح الأمس أن يكونوا مدانين بعدما تسلموا أبرز المناصب العسكرية أخيراً؟
تجارب دولية
ليست سوريا البلد الوحيد الذي شهد حرباً عنيفة ونزاعاً قاسياً وانقسامات مريرة في العصر الحديث، فثمة دول شهدت أحداثاً مشابهة، ومنها مَن تمكن من الخروج من عباءة الأنظمة الديكتاتورية، ولعل النماذج التصالحية التي طُبقت في تلك الدول بعيد صراعاتها تصلح لإسقاطها على الحال السورية والاستفادة منها، وعلى رأس تلك التجارب تكوين لجنة مصالحة آلفت المجتمع الجنوب أفريقي في ما بينه عقب سقوط نظام الفصل العنصري، وعبر تلك اللجنة مُنح كثر العفو مقابل الاعتراف ومن ثم وُلِدت بيئة جديدة من التسامح والتعايش، كذلك رواندا التي شهدت إبادة جماعية، فلجأت الدولة بعد انتهاء النزاع إلى المحاكم الرسمية وإلى نظام العدالة التقليدي القبلي المتبع كعرف ضمن المجتمع المحلي، مما أسهم في تسريع المحاكمات وإعطاء الضحايا فرصة لمواجهة جلاديهم قبل الوصول إلى إطار اجتماعي تسوده المصالحة، وأيضاً تجربة البوسنة والهرسك التي شكلت محاكم لكبار مجرمي الحرب والمتورطين بالإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في إطار برنامج متكامل لإعادة التوطين وبناء مؤسسات مدنية تعزز التعايش السلمي في خطوة نحو محو الماضي المؤلم.
اندبندنت عربية
—————————————
العدالة الانتقالية في سورية بوصفها طريقاً للسلام/ د. مازن أكثم سليمان
بعد مرور حوالي أربعة عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية، وتحوُّلها إلى حرب دموية شنها النظام البائد ضد الشعب السوري، مُدمِّراً عبرها بنية الدولة، ومُمزِّقاً وحدة المجتمع السوري ونسيجه الاجتماعي والوطني، برزت الحاجة المُلحَّة إلى إعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة، لعلَّ أهم مداخلها هو العدالة الانتقالية.
بدأ استخدام مفهوم العدالة الانتقالية حديثاً في البلدان التي عاشت صدامات اجتماعية كبرى، وأحداثاً عنفية ودموية منظَّمة وعشوائية انتهكت القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانطوت على المجازر والقتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والتطهير العرقي أو الطائفي، ولهذا تُعنى هذهِ العدالة بالضَّحايا قبل أي اعتبار ثانٍ.
تهدف العدالة الانتقالية إلى طي ملفات الماضي، لكنْ ليس على أساس النسيان؛ إنما على أساس الاعتراف بما جرى، وكشف الحقائق، ومحاكمة المجرمين والمتورطين، وتضميد الجراح الوطنية والاجتماعية، وتعويض الضحايا قانونياً ومادياً ومعنوياً. وهي شروط ملزمة وضرورية لانتقال المجتمع إلى حالة الاستقرار المُستدام والمصالحة والسِّلم الأهلي وحكم القانون ووضع عقد اجتماعي عادل وجديد، ينهضُ على حوار وطني شفاف وجادّ ومفتوح، ويمنع تكرار ما حدث.
غير أنَّ ما يميز ملف العدالة الانتقالية هو تعقيده وتشابكه مع الحقول السياسية والقانونية والاجتماعية والنفسية من جهةٍ أولى، واختلاف آلياته وتفاصيله وفق تجرِبة الاستجابة لحاجاته في كل مجتمع من المجتمعات التي مرَّت بمثل هذا النمط من الحروب والانتهاكات الجسيمة من جهةٍ ثانية.
فهو شبكة متكاملة من القوانين والإجراءات والمسارات المركبة والمتراكبة التي يتمُّ بناؤها تبعاً للظروف والمُعطيات الموضوعية، وتعمل عليها ووفقها المجتمعات الأهلية والمدنية والسلطات المحلية بالمُشاركة الأممية.
من أين نبدأ؟ أو كيف نبدأ؟
قد يكون السؤال الأوَّلي في حالتنا السورية هو: من أين نبدأ؟ أو كيف نبدأ؟
لعلَّ الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى مهمة جداً، فتجربة الأرجنتين {1} مثلاً بعد الحرب القذرة (1976 _ 1983) تكشف بعض آليات الانطلاق التي يمكن أن تقوم بها المجتمعات والقوى المدنية المتضامنة مع عائلات الضحايا، بدءاً من جمع الشهادات وتوثيق الأحداث والانتهاكات وحفظ الذاكرة الجماعية ومراكمة النضال.
العدالة الانتقالية
وهذا جانبٌ ممَّا قامت به أمهات وجدات المفقودات والمفقودين عبر وقفاتهم كل يوم خميس بأوشحتهن البيضاء في ساحة مايو في قلب مدينة بوينس آيرس حاملاتٍ صور أولادهن وأحفادهن المفقودين والمغيبين، مما مثل نضالاً سلمياً طويلاً وتراكمياً ضاغطاً على القرار السياسي وعلى المؤسسة العسكرية وصولاً إلى كشف الكثير من الحقائق.
يُعدّ أيضاً أنموذج سيراليون للعدالة الانتقالية الأنموذج الأكثر شهرة في إفريقيا، حيث تأسست (لجنة الحقيقة والمصالحة) التي أقامت جلسات وتواصل مع الضحايا والجناة، وأجرت تحقيقات موسعة وعميقة، وفكَّكت طبيعة الصراع المعقدة، وعملت على نحوٍ متزامن ومواز لعمل (المحكمة الجنائية الدولية)، وهو الأمر الذي يُبيِّن أن العدالة الانتقالية تحتاج إلى جملة من المقاربات المتكاملة، والتي تستمدُّ مسارها من طبيعة الواقع والبيئة الاجتماعية والسياسية في كل بلد.
وفي سورية يتم الحديث حالياً، بعد مطالبات وطنية واسعة، عن قرب إعلان تأسيس هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وهيئة وطنية للمفقودين، وبما أنَّ أية مُقارَبة متكاملة وأصيلة لتنفيذ العدالة الانتقالية تقوم على الحقوق الأربعة المعترف بها دولياً: الحقيقة، العدالة، جبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، يتطلع السوريون جميعاً، وعائلات الضحايا إلى محاكمة رموز النظام السابق، وجميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتفعيل القوانين التي تُجرِّم إنكار جرائم الأسد، والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين.
إنَّ شرط تحقيق هذهِ العدالة المُبتغاة يحتاج إلى معايير قانونية واضحة، وضمانات جادَّة ونافذة، ومرجعيات قضائية فاعلة، وآليات إجرائية حيادية، وتشاركية وطنية وأهلية ومدنية عريضة، تكونُ عائلات الضحايا ممثَّلةً فيها على نحوٍ مُؤثِّر بمعنى الكلمة.
لابدَّ إذن من العدالة الانتقالية في حالتنا السورية، فهي أحد أهم المسارات التي تُرمِّم النسيج الاجتماعي والأهلي، وتبني الثقة بين الدولة والمجتمع، وتساعد في إعادة تشييد العقد الاجتماعي على أساس المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
إنَّ تجذير ثقافة الاعتراف بما جرى بوصفها مدخلاً لثقافة الاعتراف بالتعددية والاختلاف، وهو ما يُمثِّلُ مدخلاً إجباريَّاً لتنفيس الاحتقان الاجتماعي، ووأد خطابات الكراهية والتحريض والعنصرية، وإعادة دمج السوريين في بنية وطنية تواصلية وتراحمية جوهرها المواطنة والمساواة والتشاركية السياسية.
ربَّما لا تتحقَّقُ العدالة الانتقالية دفعة واحدة، أو إثر تشكيل هيئة معينة حالية أو مستقبلية، فهي مسار طويل ومعقد يمر بمنحنيات عدة، ويتطلب تدابير قانونية وعُرفية في آنٍ معاً، ولعلَّ هذهِ التدابير تحتاجُ بدورها إلى إصلاحات مؤسساتية وعمليات هيكلة واسعة، لتمكين لجان الحقيقة والمُساءَلة من ممارسة واجبها بدءاً بالمحاسبة، وانتهاءً بترسيخ بيئة وطنية واجتماعية آمنة تضمن السِّلم الأهلي المُستدام، وعدم تكرار ما حدث.
ولهذا على المجتمع المدني أن يُبادر باستمرار، وأن يتصدَّى لدوره في دعم الوقفات التضامنية، واللقاءات الأهلية والمجتمعية، ودعم عائلات الضحايا بطرق مختلفة، والتشبيك مع الحقوقيين والناشطين والقوى السياسية، وبناء الملفات تراكمياً من الأدنى إلى الأعلى، وذلكَ بدءاً من جمع الشهادات وتوثيق الأحداث والانتهاكات، وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، وقضية إعلام ورأي عام يُفرَضُ فرضاً، فلا بديل عن العدالة الانتقالية على طريق بناء دولة مواطنة حديثة وعادلة.
المصدر: صدى الجنوب
—————————-
جنود نظام الأسد المخلوع في سوريا: ما مصيرهم على ضوء التجارب الدولية؟/ باسل المحمد
2025.05.23
على الرغم من إعلان الإدارة السورية الجديدة فتح باب التسويات أمام جنود وضباط النظام السابق قي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن الإقبال على هذه المراكز لا يزال محدوداً، مقارنةً بعشرات الآلاف الذين خدموا في صفوف قوات النظام المخلوع وأجهزته الأمنية، إذ يثير هذا التردد تساؤلات جوهرية حول غياب الثقة بجدية التسوية والخوف من المحاسبة.
فمع سقوط الأنظمة السلطوية تقف الدول على مفترق طرق حساس؛ كيف تتعامل مع من قاتلوا دفاعاً عن النظام السابق، خصوصاً الجنود والعناصر الأمنية الذين كانوا جزءاً من آلة القمع؟ في سوريا يبرز هذا السؤال بإلحاح مع تصاعد الحديث عن العدالة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، فجنود الأسد الذين شاركوا في قمع الشعب السوري خلال سنوات الثورة أو التزموا الصمت في مواجهة الانتهاكات، يشكلون تحدياً حقيقياً لسوريا الجديدة من الناحية الأمنية والاجتماعية لا يمكن تجاوزه بسهولة.
لكن سوريا ليست وحدها من واجهت هذا التحدي، فقد خاضت دول مثل جنوب إفريقيا، ورواندا، والعراق تجارب مؤلمة في التعامل مع إرث الجيوش المرتبطة بأنظمة سابقة، وسعت كل منها لوضع مقاربة خاصة تراوحت بين العفو والمحاسبة والدمج. فما هي أبرز الدروس التي يمكن الاستفادة منها في الحالة السورية؟ وهل من طريق وسط بين العدالة والاستقرار؟
التجربة الرواندية: دمج مدروس ومصالحة عبر العدالة المجتمعية
بعد الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص خلال مئة يوم، كان على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع مجتمع ممزق ونسيج اجتماعي مهشّم، إضافة إلى وجود آلاف الجنود والمقاتلين المنخرطين في أعمال القتل أو المتواطئين معها. لم يكن التحدي مقتصراً على نزع السلاح أو تفكيك الميليشيات، بل كان مشروعاً أوسع لإعادة بناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية.
ولم تلجأ رواندا إلى الانتقام أو الإقصاء الكامل، بل اختارت مساراً وسطاً يزاوج بين العدالة والمشاركة. أنشأت الدولة محاكم تقليدية تُعرف بـ”الغاتشاتشا”، هدفت إلى فتح قنوات للحوار المجتمعي، وتحقيق قدر من الإنصاف للضحايا من دون إغراق الدولة في إجراءات قضائية معقدة وطويلة.
في الميدان العسكري، اتبعت الحكومة سياسة تدقيق شاملة سمحت بدمج نحو 10,500 عنصر من الجيش السابق في الجيش الوطني بين عامي 1995 و1997، تلاها دمج أكثر من 39,000 من أفراد الميليشيات السابقة خلال الفترة ما بين 1998 و2002. تم ذلك وفق ضوابط صارمة هدفت إلى ضمان ولاء هذه العناصر للسلطة الجديدة، وإبعاد من تورطوا في الجرائم الكبرى من دون مساءلة أو مراجعة.
وامتد هذا النهج إلى المقاتلين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين جرى تجنيدهم قسرياً خلال الحرب، فقد منحتهم الدولة فرصة للإقامة القانونية أو التجنيس، مقابل التخلي عن السلاح والانخراط في الحياة المدنية أو في المؤسسات الرسمية تحت إشراف الدولة.
تُعد هذه المقاربة نموذجاً لسياسة “الدمج المشروط”، إذ لم يُنظر إلى الجنود السابقين ككتلة واحدة يجب اجتثاثها، بل كأفراد يمكن إعادة تأهيلهم واستيعابهم ضمن مشروع وطني جامع، مع الحرص على أن لا يكون ذلك على حساب الضحايا أو على حساب السلم الأهلي.
جنوب إفريقيا.. بناء جيش تحت العدالة الانتقالية
بعد انهيار نظام الفصل العنصري عام 1994، كان على جنوب إفريقيا التعامل مع تحدي دمج القوات العسكرية السابقة، التي شاركت في قمع وحملات عنف ضد المواطنين السود، في جيش وطني واحد يعكس التعددية الجديدة ويرسخ السلام. لم يكن الأمر سهلاً، إذ كان يجب التعامل مع أفراد كانوا جزءًا من آلة قمعية، مع ضمان عدم إعادة إنتاج العنف أو التفرقة داخل المؤسسة العسكرية الجديدة.
اتبعت حكومة جنوب إفريقيا خطة شاملة لإعادة دمج الجنود من الجيش النظامي السابق، فقد دمجت قوات الدفاع الوطني للجنوب الإفريقي (South African Defence Force – SADF)، وقوات التحرير مثل أجنحة النضال المسلح لحركات التحرر جنبًا إلى جنب مع قوات غير نظامية أخرى. شملت العملية برامج إعادة تأهيل مكثفة وتدريبات مشتركة، إضافة إلى مراجعة للسجلات لتحديد من تورط في انتهاكات جسيمة، مما سمح باستبعاد بعض العناصر من الخدمة.
كما تم تأسيس آليات إشرافية لضمان ولاء الجيش الجديد للدستور الديمقراطي، مع التركيز على بناء ثقافة عسكرية جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الوحدة الوطنية. ورغم التحديات العديدة والصراعات الداخلية أحيانًا، تمكنت جنوب إفريقيا من خلق جيش موحد يضم أعداء سابقين، وهو إنجاز أساسي في مسيرة الانتقال الديمقراطي.
البوسنة والهرسك.. جيش وطني وسط الانقسامات العرقية
تُعد تجربة البوسنة والهرسك بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995 نموذجاً بارزاً في جهود تفكيك الصراعات المسلحة وإعادة دمج المقاتلين ضمن بنية دولة موحدة. وسط انقسامات عميقة على أسس دينية وعرقية، ومع استمرار الشروخ المجتمعية، واجهت البوسنة تحديات ضخمة في بناء جيش وطني جديد وتحقيق المصالحة الوطنية، بمساندة ودعم دولي واسع.
بعد توقيع اتفاق دايتون عام 1995 الذي أنهى الحرب الأهلية، بدأت البوسنة والهرسك بتنفيذ برامج خاصة لجمع الأسلحة وتسريح ودمج المقاتلين السابقين من مختلف الفصائل، مدعوم ببرامج تأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي، ما ساعد على تخفيف آثار الحرب وتحفيز المقاتلين على الانخراط في الحياة المدنية وسوق العمل.
وعلى المستوى العسكري، أشرفت قيادة دولية على إعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج فصائل الكروات والبوسنيين والصرب في جيش وطني موحد قائم على نظام الحصص العرقية لضمان التوازن، إذ وصل عدد أفراد الجيش إلى نحو 8,800 جندي موزعين بين المكونات الرئيسية.
أما بالنسبة للمقاتلين الأجانب، فقد تم تجنيس بعضهم تحت ضغوط دولية، إلا أن أحداث 11 سبتمبر 2001 أدت إلى مراجعة أوضاع هؤلاء، وفرض قيود وعمليات ترحيل على من ثبت حصولهم على الجنسية بطرق غير قانونية.
حل الجيش العراقي.. وإشعال فتيل التطرف
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 نتيجة للغزو الأميركي-البريطاني، أصدر الحاكم المدني الأميركي للعراق، بول بريمر قرارًا صادمًا بحلّ الجيش العراقي وقوات الأمن بشكل كامل، بموجب القرار رقم 2 في 2 مايو 2003. هذا القرار أدى إلى تسريح ما يقارب نصف مليون ضابط وجندي وعامل أمني، ما خلق فراغًا أمنيًا هائلًا، وترك أعدادًا كبيرة من العسكريين عاطلين عن العمل، من دون رواتب أو دعم، مما دفع كثيرين منهم إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة متطرفة انتقامًا وطلبًا لاستعادة دورهم.
حاولت السلطات العراقية لاحقًا تدارك هذه الأزمة بإعادة تشكيل جيش جديد، ودمج بعض العناصر السابقة، خاصة من المكون الشيعي، وإطلاق برامج مثل “الصحوات” لاستيعاب مقاتلي العشائر السنية، ومنحهم رواتب ووظائف في القوات الأمنية، لكنها لم تنجح إلا جزئياً في إعادة الاستقرار، إذ عاد عدد من هؤلاء المقاتلين إلى حمل السلاح، مما ساعد على انتشار الفوضى الأمنية والاقتتال الطائفي، وانبثاق تنظيمات إرهابية كـ”داعش”، التي سيطرت على مساحات واسعة في العراق.
القرار الأميركي بحلّ الجيش العراقي اعتُبر لاحقًا خطأً فادحًا، اعترف به مسؤولون أميركيون كبار، إذ تسبب في تفكك منظومة الأمن واستغلال الفراغ من قبل الجماعات المسلحة. في المقابل أكد عدد من القادة العسكريين الأميركيين أن إبقاء هيكل الجيش وإعادة تأهيله كان من الممكن أن يقلل من الفوضى ويحد من التطرف.
ماذا عن سوريا؟
يبدو واضحا بأن تجربة العراق في تفكيك الجيش السابق من دون خطة بديلة واضحة، كانت واحدة من أكبر الأخطاء التي مهّدت لظهور جماعات متطرفة وبيئة أمنية هشة، أعادت إنتاج العنف والانقسام الطائفي، وذلك بحسب الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة نوار شعبان، الذي يرى أن النموذج العراقي “قدّم تجربة سلبية، حيث تم تفكيك الجيش بقرار فوقي، ما أدّى إلى فراغ أمني وخلق بيئة خصبة لنشوء جماعات مسلحة وهويات طائفية مسيّسة”.
لكن شعبان الذي شارك في إعداد دراسة حملت عنوان “إعادة بناء الأمن في سوريا” يرى أن الحالة السورية تختلف من حيث البنية الاجتماعية والتغلغل الأمني، ويقترح الاستفادة من تجارب أخرى مثل جنوب إفريقيا، التي طبّقت نموذج إدماج تدريجي مشروط قائم على تقييم فردي ومهني، وكذلك من تجربة رواندا، التي نجحت في تفكيك البنية الأيديولوجية للنظام السابق وإعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية.
ويقترح شعبان في حديثه لموقع تلفزيون سوريا عدة خطوات واقعية للتعامل مع ملف جنود الأسد منها؛
تصنيفهم إلى فئات: من لم يرتكب جرائم يمكن دمجه بعد إعادة التأهيل، والمتورطون يُحالون إلى مسار العدالة، والقيادات العليا تُعزل سياسيًا وقانونيًا، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية، ويتم ذلك بحسب شعبان بإشراف دولي حقوقي وتقني على كامل العملية، لضمان الشفافية ومنع الانتقام أو إعادة إنتاج الاستبداد.
من ناحيته يرى الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية محسن المصطفى أن التجارب الدولية في إعادة هيكلة الجيوش بعد النزاعات – مثل العراق ولبنان وجنوب إفريقيا ورواندا – يمكن أن تقدم دروسًا مُلهمة لا وصفات جاهزة، لأن الحالة السورية لها خصوصيتها المعقدة.
ويقترح المصطفى في حديثه لموقع تلفزيون سوريا اعتماد برنامج متكامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، مشددًا على أن إعادة الدمج يجب أن تشمل ليس فقط انخراط بعض العناصر السابقة في الجيش الجديد، بل أيضًا إعادة تأهيلهم كمواطنين فاعلين ضمن مجتمعاتهم.
ويؤكد أهمية استثناء المتورطين بانتهاكات من هذا المسار، وإخضاعهم لآليات العدالة الانتقالية، مع إمكانية الاستفادة من الكفاءات التقنية والفنية التي لم تتورط في الجرائم، ضمن مشروع بناء مؤسسي جديد قائم على الكفاءة والمساءلة.
تلفزيون سوريا
——————————
=============================