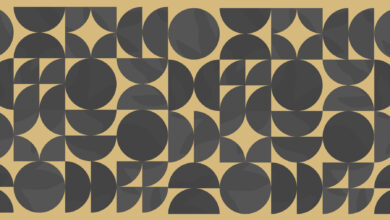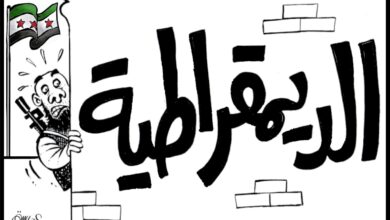في البدء كانت السلطة؟: التفكير بسؤال السلطة بوصفه المدخل اللازم للتفكير بسؤال الفاعلية/ حازم السيد

23-05-2025
ستة أشهر مضت على انهيار النظام، تأرجحنا فيها على وقع الكثير من الأحداث والانفعالات، لينتهي بعضُنا إلى موقع المُتفرِّج، ويسكننا خليطٌ غريبٌ من الأمل والقلق والترقب، والكثير من الارتباك قُبالة سؤال الفاعلية، والذي لا بد من الإجابة عليه للانتقال إلى موقع الفاعل.
يتطلب التفكير بهذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه امتلاك رؤيةٍ شاملة للمشهد السوري المعقّد، وتفكيراً مُركَّباً بأسئلته الشائكة والمترابطة، ولكن، وكي لا يبقى التفكير بهذه الأسئلة إنشائياً، لا بدّ من البدء من أكثرها بنيويةً؛ سؤال السلطة، طبيعتها ومشروعها واحتمالاتها. ستحاول هذه المقالة القيام بذلك، وعَينُها على ما يمكن فعله بعد انهيار النظام، إثر ثورة شعبية وحرب أهلية طويلة عرفتها سوريا، وحرب إقليمية تمحي غزّة لتغيّر وجه الشرق الأوسط، وفي عالم مأزوم، لا تتوقف وحوشه عن التناسُل.
سلطة غامضة وهزيلة، فوق رمال سوريا المتحركة
عشية انهيار النظام، هجس السوريون بالأسئلة نفسها: هل نحن ماضون نحو سلطة ظلامية تُحوِّلُ سوريا إلى إمارة إسلامية؟ أم نحو سلطة تَشارُكية تُدير المرحلة الانتقالية؟ أم نحو «سوريا أموية» تهيمن عليها «سُنّية سياسية» ترتكز على بعض النخب الإسلامية التي أفرزتها تجربة الثورة السورية؟ أم نحو نسخة أكثر سلطوية من هذه «السُنّية السياسية»، تنتهي بتدشين «سوريا الشرع»، وما يعنيه ذلك من بؤس وظلامية عَرفَهُ عراق نوري المالكي؟
المفاجآتُ السارّة التي شكلها انضباط عناصر الهيئة خلال عملية «ردع العدوان»، والخطابُ الوطني لقائد العملية أبو محمد الجولاني ومَنبتُهُ العائلي، والتغيرات الكبرى في خطاب وممارسات هيئة تحرير الشام خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة التنظيمية والإيديولوجية والعقائدية؛ أمورٌ جعلت قطاعات واسعة من السوريين تأملُ أن يكون لسؤال السلطة إجابةٌ أكثر تطميناً ممّا كانوا يتوقعون من ميليشيات الشمال. ولكن الأسابيع التالية جعلتنا ندرك أن الترحيب الإقليمي والدولي بالسلطة الجديدة لم يكن إلا بداية مسار طويل ومعقد، ومفتوح على الاحتمالات، وأنه لا يمكن التعرف على اللون النهائي للسلطة في سوريا قبل الوصول إلى خواتيمه.
سلطةٌ خاضت معركة ردع العدوان بحوالي 30 ألف مقاتل، لا يتجاوز عدد مقاتلي الهيئة بينهم 14 ألف مقاتل، ولم تُطوِّر خلال «التجربة الإدلبية» إلا جهازاً بيروقراطياً من عشرة آلاف موظف مدني1، وفقاً للباحث السويسري المتخصص في الحرب الأهلية السورية باتريك هاني؛ سلطةٌ كهذه لا يمكن مقاربتها إلا بوصفها سلطة هزيلة. وكي تتمكن من «ملو هدومها» والتخلص من ماضيها غير المُطمئن، لا بد لها من الحصول على تمويل إقليمي، وهو ما يتطلب ضوءاً أخضراً أميركياً، والذي يتطلب بدوره سلطة أكثر تطميناً. حتى أيام قليلة، سارعَ دوران السلطة في هذه الحلقة المفرغة من انكشاف هُزالِها، وهو ما يبدو وكأنه قد دفعها نحو المزيد من الذعر والسلطوية وما أفقدها قدرتها على تطمين عموم السوريين.
كانت مجازرُ الساحل الحدثَ الذي أعلن عن وصول هذه الحلقة شبه المفرغة التي تعيشها السلطة إلى واحدة من ذُراها، حيث يبدو أن فزعها من اشتعال جبهة الساحل في وجهها قد قادها إلى التواطؤ مع دعوات النفير العام، لتقوم بعض ميليشياتها وميليشيات رديفة، طائفية وظلامية، بارتكاب عشرات المجازر في الساحل السوري وجبال العلويين. من ناحيةٍ ثانية، جاءت الاستباحة الإسرائيلية والتردد الأميركي لتُعرّي هذه السلطة من واقعية وعودها، وتساهمَ في تسريع وتيرة تآكل مشروعيتها الداخلية، فقد تسبّبَ ذلك بتأجيل إطلاق ديناميات إعادة الإعمار وإعادة هيكلة الدولة، بل ومَنعِها من إطلاق بعض ديناميات التعافي الصغرى، لتتحوَّلَ السلطة إلى وعد مُؤجَّل بتحسُّن الأوضاع 400 بالمئة، وليبدو كأنَّ رفضها لمنطق التشاركية والتفاوض، وقلّة كفاءة الكثير من وجوهها، وانكشاف عجزها عن ضبط الميليشيات، واستخدامها لتقنيات الاستزلام وأساليب الحرب الأهلية لترويع بعض الأقليات، الأسبابَ الكبرى للاستعصاء. بالإضافة إلى ذلك، تسبب عَجزُها عن إطلاق ديناميات التعافي بتحوّل «الدولة السورية الجديدة» إلى ماكينة لفصل الموظفين واعتقال بعض وجوه نظام الأسد بهدف التنفيس عن احتقان البيئات المرتبطة بالثورة، وبشكل شديد الانتقائية، يمكن تفسيره باستخفافها بطلب السوريين للعدالة والمحاسبة، أو بخوفها من اشتعال جبهة جديدة في البيئات المرتبطة بالنظام المنهار ورُعاته، أو بخوفها من أن يتسبَّبَ تَنازُلها الرسمي عن الأساس الشرعي لسلطتها القضائية لصالح منظور أكثر عصرية، بانقطاع شعرة معاوية بينها وبين بطانتها السلفية، وما قد يعنيه ذلك من احتراب داخلي.
جاء إعلان ترامب عن رفع العقوبات الأميركية، ومصافحته للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، ليضع حداً لهذه المناخات ويطوي صفحتها، ويُعيدَ إنعاش أجواء الأمل والتفاؤل بإمكانية العودة إلى سوريا طبيعية، تشبه محيطها؛ النظام الرسمي العربي، وتعيش فيه بتناغم، وهو ما أكدت عليه كلمة الشرع المقتضبة، والتي شكر فيها حلفاء سوريا الإقليميين على احتضانهم ودعمهم، ودعا السوريين إلى الاستثمار في وطنهم، دون أي تلميح أو كلام في السياسة، فيما عدا التذكير برفضه النزعات الانفصالية.
في المقابل، وإن أوحى رفع العقوبات بإمكانية عودة سوريا المركزية الموحدة، تبقى قسد عقبةً كبيرة أمام هكذا طموح، ويمكن أن تجرَّ محاولة مواجهتها إلى فصل طويل آخر من فصول الحرب الأهلية. على الجانب الآخر، التعايشُ مع قسد سيقود السلطة إلى قبول التعددية السياسية التي لا يبدو أنها تشكل واحدة من أولوياتها. وما يزيد من هشاشة المشهد، رغم رفع العقوبات، أن ملفَّ مجازر الساحل لم يطوَ بالمعنى السياسي للكلمة، فاللّجنة التي قامت السلطة بتشكيلها للتحقيق في ملابسات المجازر مددت مهلة عملها، ولم تغادر كثيرٌ من الفصائل المتورطة في مجازر آذار مواقعها. بالإضافة إلى ذلك، استغلال «فتنة طائفية» هزيلة لإطلاق حملة لترويع وإرهاب دروز سوريا في محيط دمشق ومحافظة السويداء عزَّزَ القناعة بأن مجازر الساحل لم تَكُن مجرد أحداث خارجة عن السيطرة، وإنما تقنية قد تعتاد السلطة على استخدامها في وجه من يعارضها.
بالمحصلة، يشكل رفع العقوبات نقلةً نوعية في مصير هذه السلطة، ويمنحها ما تحتاجه من الاسترخاء لكشف مشروعها وبلورة خطابها تجاه الداخل السوري بعد أشهر من الصمت والتيليغرام، ولكن هشاشة الترحيب الأميركي والتحالفات الإقليمية الراعية بين السعودية وتركيا، والهمجية الإسرائيلية ورغبتها في «ترتيب جديد» للإقليم، تُذكِّرنا بأن سؤال السلطة لم يحصل بعد على جوابه الشافي، وأنه لا زال مفتوحاً على احتمالات الاستبداد الظلامي.
إعلان الحرب على السلطة: إنشاء ركيك وواهم؟
أمام هذا الاحتمال يكتسبُ الخط الداعي لمجابهة هذه السلطة بعض المشروعية، فلا يمكن، بحسب هذا الخطاب، التعامل مع «سلطة تنظيم القاعدة» إلّا بالرفض المطلق لها ولمشروعها، واعتبارها عدواً، لا مجرد خصم، يجب التصدي له باستخدام كل ما يمكن من الأوراق.
الاستباحة الإسرائيلية التي استهدفت ما تبقى من الترسانة العسكرية للنظام القديم، وعادت لتستهدف النظام الجديد في مطلع أيار (مايو) بحجة حماية دروز سوريا، بل وقامت بطلعات وقصف جديد بعد زيارة ترامب لتؤكد على تَمسُّكها بسماء سورية مفتوحة، تبدو لأنصار هذا الخط وكأنها تقول إنها لن تقبل التطبيع مع هذه السلطة، وإنها، عاجلاً أم آجلاً، ستستغلّ جبروتها لتحطيم «سلطة إرهابية» لا يمكن إلا أن تكون خطراً وجودياً على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هشاشة التحالف الإقليمي بين السعودية وتركيا، وجِدَّته وتدشينه في الأرض السورية الحافلة بالتعقيدات التي قد تتسبب بانفراط عقده، بالإضافة إلى هوائية الرئيس الأميركي وتمسُّكه بعلاقته الطيبة مع ناخبيه من الإنجيليين، الداعمين لعدوانية إسرائيل، وصعوبة وصول مسار التفاهم بين أنقرة وأوجلان، ودمشق وقسد، إلى خواتيمه، بسبب الهوّة الإيديولوجية الكبيرة التي تفصل هذه القوى؛ كلّها أمورٌ تجتمع لتقول إن الشرق الأوسط الوديع الذي يُبنى اليوم ليس إلا قلعةً رملية، وهو ما يضفي على خطاب الرفضِ بعض المشروعية، لا بوصفه تعاوناً مع العدو الإسرائيلي، وإنما دعوةً للتحضير لملئ الفراغ الذي سيعقب انهيار المسارات الحاليّة.
بالمقابل أيضاً، لا يوجد الكثير مما يدعو إلى اعتبار أن عدوان إسرائيل مستندٌ على رؤية واضحة لما تريده لسوريا، فرغم أن مُسيَّراتها قد حامت في سماء صحنايا، إلا إنها قد سمحت في نهاية المطاف لهذه السلطة بانتزاع سلاح الميليشيات الدرزية في منطقة شديدة الاستراتيجية كمحيط دمشق، ليتحول دروز صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا إلى «رهينة» في يد السلطة، وهذا يمنعُ الهجري، أحد أبرز رموز خط الرفض وأهمّ زعماء واحدة من أكثر الجماعات السورية مُحافَظةً واحتراماً لحرمة دم أبنائها، من المضي بعيداً في رهانه، ويُفشِلُ مناورته القائمة على استخدام نفوذ دروز إسرائيل للتحول إلى خصم وازن أمام زعيم ميكافيلي كالجولاني بما يضمن المضي نحو دولة مدنية وتعدّدية، أو للحصول على حصانة درزية، أو للتحول إلى الزعيم الأوحد للطائفة، أو أياً كانت مشاريعه وطموحاته.
زيارة ترامب في الأيام الأخيرة، والتي تمخضت عن إطلاق مسار رفع العقوبات الأميركية، واستجابة السلطات السورية السريعة وتعبيرها عن إمكانية التفاوض، ودعوة زعيم دروز إسرائيل إلى «سوريا موحدة»، وتصريحات الخارجية الإسرائيلية عن الرغبة بـ«علاقات جيدة مع سوريا الجديدة» و«عدم رغبتها بالتدخل في هوية نظام دمشق»، توحي بأن إسرائيل لم تعد عدواً لطرفي الخصام، وتسلبُ الاستباحة الإسرائيلية قُدرتها أو رغبتها بتحطيم السلطة السورية أو حتى الدفع باتجاه لامركزية أو فيدرالية سورية.
بالإضافة إلى ذلك، قطعَ مسار التفاهم التاريخي بين السلطة التركية وأوجلان، وبين سلطات دمشق وقسد، خطوات شديدة الجدّية، فقد أعلنَ حزب العمال الكردستاني عن حله لنفسه قبل أيام، وقامت قسد بتسليم أحياء حلب الكردية وتحييد سد تشرين، كما عاد كثيرٌ من مهجري عفرين، من الكُرد، إلى ديارهم، وهو ما يسلب هذا الخطَّ الحاملَ السياسي والعسكري الأقدر على مقارعة السلطة الحالية، وما يؤكد بأن مسار تطبيع هذه السلطة مع الإقليم والعالم وتفاهماتها مع القوى التي أفرزتها سنوات الحرب، تجتمع لتضعها على سكة استيفاء شرعيتها الدولية.
تواضع الأوراق التي في حوزة هذا الخط الداعي لمجابهة للسلطة، الذي يلتقي فيه مثقفون تنويريون ويساريون ولائيكيون مع أعيان المكونات وناشطيها، تُترجمها هزالة إنشائه، وعقمه السياسي، واجتراره لمقولات شديدة الإيديولوجية والماهوية، بل والطائفية، ليبدو، في أحسن أحواله، عاجزاً عن السباحة إلا في مستنقعات المضاربة في خطاب نقد النخب وسؤال المسؤولية، أو إشباع فوقيته عبر إخضاع الأمة والثقافة والمخيال للتحليل النفسي وتحليل الأبعاد الإبادية للمظلومية السنية والتأمُّل الميتافيزيقي في ماهية الكيان السوري ومكوناته، وليبدو -حين يتحدث في السياسة- عاجزاً عن إنتاج ما يتجاوز الوعيد والنكاية أو الاستقالة، وليكون أكثر من يتقاطع في الرثاثة مع مُحدَثي السلطة من مثقفي «السُنّية السياسية» الصاعدة.
الضغط على السلطة: «الغرب» لضمان التعددية وحقوق الأقليات؟
بالمقابل، أعطت قلة كفاءة السلطة وكاريكاتورية حوارها الوطني وإعلانها الدستوري، عدا عن مجازر الساحل وحملة ترويع الدروز وإرهابهم، الكثيرَ من الشرعية لخط الضغط الذي إن كان يمكن أن يعترف لسلطات الأمر الواقع ببعض الشرعية، سواء الثورية أو الأمنية أو الإيديولوجية، فإنه لا يرضى بأن يتناسى ماضيها الأسود ونشأتها المشبوهة، ولا أن يتغافل عن أدائها الكارثي وقلة كفاءتها على أكثر من صعيد في الأشهر الماضية. لا يَعتبِرُ هذا الخط السلطة عدواً وطنياً لسوريا، إلا أنه يعتبر بأنها لا تستحق إلا الخصومة سياسياً، وأنه لا بد من استخدام ما بحوزته من أوراق للضغط عليها وإجبارها على تقديم المزيد من التنازلات نحو سلطة تَشارُكية تعددية تلتزم بروح قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
أغوى هذا الخط كثيراً من أبناء الأغلبية الصامتة، من أقليات دينية أو بيئات مدينية لا يتناسب نمط عيشها مع النمط الذي يمكن أن تفرضه سلطة سلفية، أو من أبناء الشرائح الاجتماعية المرتبطة بالدولة السورية السابقة أو بقطاعات مهنية مُعيّنة، قد تشهد الكثير من التهميش في ظل سوريا الجديدة، ووجد صَوتَهُ في خطاب بعض أبناء المجتمع السياسي السوري وناشطي المنظمات غير الحكومية، الذين تتجاهلهم هيئة التحرير الشام.
لا يختلف هذا الخط عن سابقه كثيراً من حيث افتقاده إلى أوراق سياسية ملموسة، فهو لا يمتلك أدنى درجات التنظيم والحضور الإعلامي الراسخ والقوة السياسية، بل ولا يمتلك القدرة على الحشد على اعتبار أن الأغلبية الصامتة التي قامت سنوات الحرب بإنهاكها وإفقارها وتطييفِ شرائح واسعة منها، من سُنّة وأقليات، تبدو أيضاً ميالة إلى الانتظار والترقب، وعاجزة عن دفع أي ضريبة قد تتطلبها معارك الضغط على السلطة. تسبب ذلك بعقم هذا الخط واقتصاره تدريجياً على إنشاء قائم على الاعتقاد بسحر الجيوبوليتيك وبأن «المجتمع الدولي» يمكن أن يكون معنياً بحقوق الأقليات أو بالتعددية السياسية في سلطة اليوم، أو أنه قد يُولي بعض الاهتمام لنداءات الحماية الدولية بعد المجازر، أو أن عقوباته قد تهتم بأي شيء آخر غير الجانب الأمني، أو أن «المجتمع الدولي»، بل و«الغرب» برمته، هي مقولات صلبة وقوى يمكن التعويل عليها في مرحلة عنوانها ترامب وإبادة غزة.
الطابع الأمني لسلطة الجولاني، وقُدرتها على الإجابة وبفاعلية على التهديدات التي قد تجسدها عودة داعش، عبر قُدرتها على امتصاص أي محاولة للمضاربة على يمينها، واعتمادها على الخبرات والعلاقات التي راكمتها في تاريخها الأسود، وعلى انضباط مقاتلي ميليشياتها وطاعتهم لأوامرها، بالإضافة إلى فقدانها لكل الأوراق التي يمكن أن تسمح لها بالتحول إلى خطر إقليمي وازن، وتعاونها وطاعتها الشديدة للمتطلبات الأميركية في تفكيك ما تبقى من ترسانة السلاح الكيماوي ومواجهة داعش، والمتطلبات العربية في تفكيك منظومة تجارة الكبتاغون أو متطلبات الأوروبيين في استقبال اللاجئين الواجب ترحيلهم، تجعلها تفي بأغلب ما قد يحتويه دفتر الشروط الإقليمي، وتجعل الشرع «أفضل أدوات أميركا ضد داعش»، على حد تعبير مقابلة اللوموند مع روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا.
إبادة غزة، ودروس السوريين مع الخطوط الحمراء المعدودة، وأوهام التدخل الدولي فيما مضى، والتخلي المتزايد لجميع القوى الإقليمية والدولية المعنية بالسؤال السوري عن أي بُعد حقوقي أو أخلاقي لسياساتها الخارجية، ودخول العلاقات الدولية، بمعية ترامب ونتنياهو وبوتين ونظرائهم، في واحدة من أكثر محطاتها انحطاطاً وسينيكية، بالإضافة إلى البُعد الأمني للسلطة الوليدة، أمورٌ تأتي لتُذكِّرَ بعض أبناء هذا الخط بأن الاعتقاد بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسكت على «حكم القاعدة» و«استهداف الأقليات»، مجرد تفكير رغبوي وادّعاء واهم.
أجواء الإذلال والهزيمة التي يعيشها الأوكران اليوم يمكن أن تُذكِّرَ من تبقى، ممن يعتقدون بأن المجتمع الدولي لم يبالِ بآلام السوريين طوال السنوات الماضية بسبب سُنّية الضحايا وأنه سيهتم بدماء الأقليات، بأن اعتقاداتهم هذه لا ترتكز إلا على وهم تفوق عنصري، لا يعكس إلا رثاثة رؤيتهم للواقع والتاريخ والسياسة.
الشراكة مع سلطة، لا تقبل إلا الاستزلام والمحسوبية والاستفراد!
مقابل خَطَّي الرفض والضغط الذين سمحت ممارسات السلطة بتوسيع صفوفهما في مرحلة ما قبل رفع العقوبات، حافظ تيار «الشراكة بالنقد» على قدرته على مُداعبة مزاج الكثير من النخب السورية، وبخاصة السُنّية، وهو ما عاود الانتعاش بعد رفع العقوبات، فإن كان لا يمكن الدفاع عن الكثير من إخفاقات السلطة في الأشهر الماضية، إلا أنه لا يبدو لهذا التيار أن مُهاجَمتها أو مُخاصَمتها يمكن أن يكون توجهاً صائباً، ومسار الاحتضان الإقليمي والترحيب الدولي يوحي بدوره بعبثية هكذا مساعٍ.
لا يكفي سحر 8 ديسمبر ورغبة نخب الثورة السورية بتحويل هذا اليوم إلى موعد لانتصار الثورة السورية، لفهم ميلها إلى التماهي أو الدعم أو على الأقل التسامح مع أداء هذه السلطة الفتية. لا يكفي كذلك شعور الامتنان الهائل الذي تكنّه بطانة هذا التيار لأبناء ميليشيات الشمال، التي لم تعرف إلا حياة الخنادق والتضحيات، والتي دفعت مجتمعاتها الضريبة الأكبر لتحرير السوريين من بربرية نظام الأسد، والتي ستُساعدها «فطرتها الشامية» على القطع مع تقاليد الميليشيا والحرب الأهلية والتحول إلى عناصر وطنية في جيش الوطن وأمنه. ولا بد من التذكر بأن الكثير من نُقّاد السلطة، ممّن يرغبون بمعاداتها أو مخاصمتها، يُحاسبونها وكأنها سلطة تتسيد على دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمات، وهو ما تُكذِّبه الوقائع، فالجولاني وهيئته ليسوا إلا مشروع سلطة تحاول إعادة إحياء جثة متهالكة هي الدولة السورية، ولم يَمضِ من الوقت ما يسمح بمحاسبتهم على أداء سلطتهم الذي لم يبدأ بعد. أداؤهم الدبلوماسي والإقليمي يكاد يبدو شديد البراغماتية بما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه السلطة لا يمكنها أن تقدّم أكثر من ذلك، وهو ما يشهد عليه رفع العقوبات الأميركية، والتي تبدو النهايةَ السعيدة لأول مَساعيهم الدبلوماسية، والإثباتَ الدامغ على براغماتيتهم ووطنيتهم وإمكانية التعويل على خططهم.
يضاف إلى ذلك حجم التعقيدات الهائل في المشهد السوري في اللحظة الحالية، فهذه السلطة تستلم مجتمعاً محطماً بشكل هائل: ما يتجاوز النصف مليون قتيل، قُتِلَ عشرات الألوف منهم تحت التعذيب، وحوالي 150 ألف بناية مدمرة في عشرات المدن والبلدات المدمرة كلياً أو جزئياً، وإعاقات تطال 28 بالمئة من السكان، و7.5 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وقرابة 3.5 مليون نازح في خيام إدلب والشمال الغربي، وانقسامات طائفية دموية، ودولة لم يتوقف سوس الفساد والمحسوبية عن نخرها منذ أكثر من 50 سنة، ومجتمع مُفرَغ من طبقته الوسطى يقع 90 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.
يقول هذا التيار إن هذه السلطة قد أصيبت في لحظة مجازر الساحل بذعر قادها إلى التسامح والتواطؤ مع النفير العام، وإن أغلب المجازر قد ارتكبت من قبل تشكيلات طائفية وأجنبية وظلامية بعيدة نسبياً عن النواة الصلبة لهذه السلطة، وإن محاولة ضبط هذه التشكيلات وإعادة هيكلتها وتذويب عصبياتها مشروعٌ لا يمكن أن ينتهي قبل وقت طويل، وإن قدرة هذه السلطة على تأسيس نواة عسكرية منضبطة نسبياً، وقادرة على إطلاق دينامية احتكار العنف هو بحد ذاته النجاح الأمني الأكبر لهذه السلطة، وأحد أهم أسباب مشروعيتها وشعبيتها. يقول أيضاً بإن خصوم السلطة، قسد والهجري، لا يكترثون بسوريا والثورة كأساطير مُؤسِّسة، ولا يطمحون إلى التعاقد من أجل بناء الدولة، وإنما إلى الحصول على استثناء وحصانة وجغرافيا لنفوذها وميليشياتها، ما يجعلها أطرافاً قليلة الأهلية في أي مَسعى تعاقدي، وما يجعل «السيادة» غير ممكنة في عالم يتعدد فيه أصحاب «الاستثناء» إن استلهمنا مقولات كارل شميت، وما يجعل هيبة الجولاني، ميكافيليته وسينيكيته، وعُنف ميليشياته، المسارَ الوحيد الممكن لاستعادة «السيادة» وطَيّ صفحة الحرب. بالإضافة، محاولة استدراك السلطة لـ«فشلها» في إدارة أيام مجازر الساحل الأولى عبر تشكيل لجنة لكشف الحقائق في مدة زمنية محددة، وقيام لجنة للسلم الأهلي، وتعزية مسؤولين بارزين ببعض الضحايا وغيرها من التفاصيل الصغيرة، تدفع لتعليق فرضية سلطة ظلامية تكشف عن وجهها الطائفي الانتقامي في المجازر، وتُعيد لتيار الشراكة بالنقد بعض مشروعيته.
بالمقابل، اعتماد السلطة على منطق المحسوبية والاستزلام عبر الاعتماد على أشقاء الرئيس أو على فلول سابقين أو على مجاهدين أجانب لقيادة الفرق العسكرية التي تقوم بتأمين العاصمة، ورفضها منطق الشراكة مع أي قوة سياسية مستقلة، والاكتفاء بتطعيم ماكينتها ببعض الوجوه التكنوقراطية، عدا عن تواضع رسائل التطمين المُعبِّرة عن رغبتها ببناء جيش وطني قادر على ضم عموم السوريين، ومحدودية الرؤى التي أطلقت هيئات العدالة الانتقالية وشؤون المفقودين، أو تسامحها مع محاولات تطبيع مناخ الرعب الذي تعيشه أرياف العلويين، تأتي لتقسم هذا التيار إلى خط يَرضى على نفسه التَحوُّلَ إلى مُسنَّن في ماكينة سلطة لا ترغب بالشراكة وما تقتضيه من ندّية، ولا يمكن أن تقبل إلا بمنطق الاستزلام، بل وقد تُجبر موظفيها على التعاون مع بعض أزلام السلطة السابقين كفادي صقر من أجل إرساء أسس السلطة الجديدة، ما يعنيه ذلك من تحولهم التدريجي أو السريع إلى أبواق وغوغاء، عرف السوريون الكثير من تنويعاتها في سوريا الأسد.
الخط الثاني، الذي لم يجد في خطاب الشرع بعد رفع العقوبات ما يبدد شكوكه في رغبة هذه السلطة بالاستبداد بكل شيء، يبدو أقربَ إلى أقلية رافضة لأدوار «اللعيّبة» و«الخريبة» على السواء، بل وميّالة إلى المساهمة في بث الروح الإيجابية إن أمكن ذلك، والاكتفاء بمراقبة المشهد إن لم يكن التفاؤل ممكناً، على أمل أن تسمح أموال إعادة الإعمار لهذه السلطة بالاسترخاء وجعل الشراكة ممكنة، ولو على مضض.
الحياة اليومية كسياسة؟
لا يبدو أن استراتيجيات «المجابهة» أو «الضغط» أو «الشراكة» قادرة على خلق فاعلية سياسية وازنة في هذه اللحظة التأسيسية، بل ولا يبدو أن للنخب السورية أي تأثير يذكر على سؤال السلطة وتَشكُّلها، وهو ما يبدو السبب الأعمق لصمت أغلب أطياف النخب السورية وتَرقُّبها، أملاً بأن تقوم أموال إعادة الإعمار بدفع السلطة نحو الاسترخاء والالتزام بمسار أكثر تشاركيةً، وما قد يعنيه ذلك من هامش أوسع وأكثر وضوحاً للعمل السياسي. وبالمقابل، ماضي السلطة القريب والبعيد وعملها على الاستفراد بإدارة هذه السنوات التأسيسية وتعقيدات المشهد السوري البنيوية، أمورٌ لا تعد بالكثير وقد تتسبب بتحوّل عودة السياسة إلى مجرد ارتفاع في منسوب الاستهلاك الإخباري.
ولكن النظام قد سقط واحتمال السياسة سيبقى قائماً ولسنوات، ولكنه قد يتطلب الخروج من «مخيال ربيع دمشق»، وقد يحتاج إلى التفكير بالسياسة بشكل مختلف. يمكننا، على سبيل المثال، التفكير بـ«الحياة اليومية كسياسة»، وما يقتضيه ذلك من استكشاف لمقولات الذكاء الجمعي والمواطنة الجذرية والفلسفة العملية وغيرها، وما يمكن أن يَعِدَ به ذلك من أشكال مُبتكَرة من الفاعلية السياسية، تحاول الاستثمار في الهامش الذي لا زال متاحاً، عبر محاولة التفكير بالسياسة كفن للعيش المشترك بعيداً عن الدولة وعن مركزية سؤال الصراع على السلطة، على أمل أن يُغيّر الناسُ العاديون الشرقَ الأوسط بهدوء أكبر، وكما «يريد الشعب» بعد أن «سقط النظام».
1.بالمقابل، تعتمد قسد على جهاز بيروقراطي من 200 ألف موظف لإدارة الجزيرة السورية، والتي يقارب عدد سكانها عدد سكان قطاع إدلب، وفق الباحث نفسه.
موقع الجمهورية