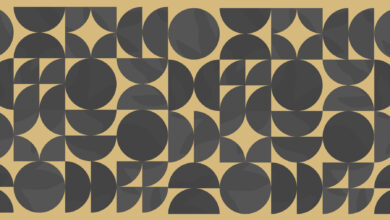من معجم القذائف اللفظية: إبداع لغوي شعبي في زمن الثورة السورية/ موسى الحالول

2025.05.22
ليس غريبًا أن تصاحبَ معاركَ الميدان بين المتحاربين قذائفُ لفظيةٌ موازيةٌ. وقد كانت القبائل العربية قديمًا تحتفل إذا وُلِدَ لها شاعرٌ كاحتفائها ببروز فارسٍ فيها، لأن هذا يُبارِز عنها بسيفه، وذاك يُطاعِن عنها بلسانه. والسوريون اليوم ليسوا استثناءً. لكني لن أركز في مقالي هذا على مساجلات النخبة من أدباء ومعلقين سياسيين، بل على المصطلحات الشعبية التي راجت في صفوف المعارضة السورية لترذيل نظام الأسد ورموزه ومُواليه منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011 إلى ما بعد سقوط هذا النظام، ذلك لأن هذه المصطلحات تعبر عن الضمير الجمعي السوري المناهض لنظام الأسد.
أحاول في هذا المقال أن أستقصي مظاهر الإبداع اللغوي الشعبي الذي رافق الثورة السورية، وذلك برصدٍ وتحليلٍ لسبعةٍ من المسكوكات اللفظية التي اجترحها السوريون في خضم الصراع، ولا سيما في صفوف المعارضة الشعبية، لتسمية الظواهر والأشخاص والسلوكيات المرتبطة بنظام الأسد وممارسات أزلامه. لا يهدف المقال إلى حصر كل ما أبدعه السوريون من مفردات ومصطلحات، بل إلى تقديم قراءة دلالية وصرفية موجزة لبعض هذه القذائف اللفظية التي كشفت عن قدرة السوريين على تحويل الألم والاضطهاد إلى مادة لغوية غنية، وكيف يمكن أن يكون للكلمة دورٌ مُوازٍ للرصاصة في سياق المقاومة الرمزية. وبين التحليل المعجمي والسخرية السياسية، أسعى إلى تسليط الضوء على تفاعل اللغة مع العنف والهوية والذاكرة في لحظة مفصلية من التاريخ السوري الحديث.
اللافت للانتباه فيما سكَّه المعارضون السوريون هو أن مصطلحاتهم تتسم بالجدة والطرافة أو حتى الفكاهة، وهذا راجعٌ، فيما أظن، إلى كونها عاميةً، ولذلك فهي عفويةٌ نابعةٌ من القلب لا تَكَلُّف فيها، وتدل على خيال شعبي خِصب، في حين نجد أن المصطلحات التي روَّج لها النظام وموالوه كانت باهتةً تفتقر إلى الأصالة والإبداع. فأغلب ما وَصَمَ به نظامُ الأسد معارضيه كان كليشيهاتٍ ممجوجةً مثل إرهابيين، طائفيين، تكفيريين، مندسين، عملاء، مأجورين، مرتزقة، إلخ. لعل الاستثناء الوحيد الذي جادت به قريحة الموالين وفيه شيءٌ من الإبداع والطرافة هو مصطلح العَراعرة (أي، أتباع الشيخ المعارض عدنان العرعور الذي كان يهاجم النظام من مقر إقامته في الرياض).
الشَّبِّيحة
حين شاعت مفردةُ “الشَّبِّيح،” كانت تعني حرفيًا الشخصَ الذي يركب سيارة “شَبَح،” وهو اسم شعبي لنوع من أنواع المرسيدس شاع في سوريا ربما منذ ثمانينات القرن الماضي. وقد كان الشبِّيحةُ (جمع “شبِّيح”) يشتغلون حينذاك في تهريب المخدرات والسجائر والسلاح والمشروبات الكحولية بين لبنان وسوريا والعراق. تميَّز هؤلاء بضخامة أجسادهم وعضلاتهم المفتولة ولِحاهم الطويلة ورؤوسهم الحليقة وقلة عقولهم وطاعتهم العمياء لقائدهم.
لكن طرأ على مفردة “الشبِّيح” تطور دلالي بعد انطلاق الثورة السورية في عام 2011. فقد انتقلت المفردة من حقل الجرائم الاقتصادية إلى حقل الجرائم الإنسانية. وقد شَكَّل الشبِّيحةُ في هذه المرحلة قواتٍ رديفةً لقوات بشار الأسد، وكان رامي مخلوف، ابنُ خاله، الممولَ الأساسيَّ لهذه القوات التي ولغت في دم الشعب السوري الثائر. ومن هذه المفردة اجترحَ السوريون فعلاً ومصدرًا (شَبَّح، يُشبِّح، تَشْبيحًا). في البداية، كان هذا الفعل يعني أن يقاتل الشبيحُ أيَّ معارض للأسد أو أن يقتله إن استطاع (وقد فعلَ الشبيحةُ بالمواطنين ما فعلوا). لكنه اليوم بات يعني أن يمارسَ أيُّ مُسْتَزلِمٍ العنفَ الجسديَّ واللفظيَّ على فئة مستضعفة. ولذلك ظهر منذ مدة قريبة مصطلح “الشبيحة الجُدُد” (على شاكلة المحافظين الجدد في زمن جورج بُش الابن)، ويُقصَد بهؤلاء الموالونَ لحكومة الرئيس أحمد الشرع. وإضافة صفة “الجُدُد” إلى “الشبيحة” تشير إلى إعادة تدوير لفظي لمصطلح قديم وبداية هجوم سياسي مضاد يدل على مرحلة جديدة في دائرة الصراع المستمر حتى الآن.
وبما أن الشيء بالشيء يُذكر، فدعونا نتوقف عند مصطلحٍ ذي صلة بهذا السياق اللغوي-السياسي، وهو “الشَّبْح”. وهذا مصطلح عرفته المعاجمُ العربيةُ (أي، مَدُّك الشيءَ بين أوتادٍ ليجفَّ) كما ورد في “كتاب العين.” لكن ليس لنظام الأسدَيْنِ فضلٌ إلا في إحياء هذا المصدر وتوسعة دلالته، إذ بات يعني تعليق السجين من رجليه من السقف وتعذيبه بالسياط وغيرها. وهكذا أصبح فعلُ “الشَبْح” فعلًا سوريًا محفوظةً حقوقُه لآل الأسد وزبانيتهم. أي، أنهم هم الذين أخرجوا هذا المصطلح بدلالته الجديدة وليس مناوِئوهم. لكن هؤلاء هم الذين أشاعوه في أحاديثهم الإعلامية ومذكراتهم بعد خروجهم أحياءً من مسالخ الأسد البشرية، وذلك لفضح أساليب التعذيب الوحشية التي اتبعها النظام مع معارضيه.
المِنْحِبَكجي
المِنْحِبَكجي، اصطلاحًا، هو الموالي الأعمى لبشار الأسد. ويعود أصل الكلمة إلى شعار “مِنْحِبَّك” (أي، نُحِبُّك) الذي انتشر على لوحات إعلانية تحمل صورة بشار الأسد بعد أن ورث “العرشَ الجُملوكيَّ” من أبيه “الخالد” حافظ الأسد في عام 2000.
ولا بد من تفكيك كلمة “مِنْحِبَكجي” للوقوف على أسرار الإبداع (أو العَسْف، إن شئتم) في اشتقاقها الصرفي. فالميمُ بادئةٌ تُضافُ إلى الفعل المضارع في بعض العامِّيات السورية، وقد تفيد التوكيد؛ أما الفعل “نْحِبَّك” العامي فيحتوي، كنظيره الفصيح، على الفعل والفاعل (وهو هنا ضمير مستتر تقديره “نحن”) والمفعول به (كاف الخطاب). أما “جي” فهي لاحقة عامية مستعارة من اللغة التركية، تُضاف إلى الاسم للدلالة على مهنة أو صفة لازمة في المُشار إليه كما في كلمة “قهوجي” أو “نِسْوَنجي،” على سبيل المثال. لكن من الناحية الصرفية، تنطوي كلمة “مِنْحِبَّكجي” على تنافر صَرفي وعددي: فهي تجمع الجمعَ والمفردَ معًا (بخلاف النحت الكلاسيكي لمصطلح “اللاأدْرِيِّ”). فَنُونُ المضارعةُ في “نْحِبَّك” تدل على جمعٍ (نحن)، في حين أن اللاحقة التركية “جي” تدل أصلًا على مفردٍ (هو). ترى، هل يدل هذا التنافر الصرفي أو العَسف الاشتقاقي على طبيعة هذه الكائنات الغريبة المُنَفِّرة؟ على أي حالٍ، ولكي لأسهم مع أهلي السوريين في إثراء خطاب المعارضة، اجترحتُ قبل عدة سنوات لهذا المسكوك اللفظي العجيب ترجمةً إنجليزيةً لا تقل عن أصلها العربي عَجبًا: we-love-you-ist.
التعفيش
شاع هذا المصطلحُ بعد موجة النزوح السوري وتهجير السكان من مساكنهم في المدن والبلدات والقرى. وكانت قُطعان الشَّبِّيحة واللصوص تدخل البيوت المهجورة و”تُعَفِّشها” (أي، تُجَرِّدها من “عفشِها،” أي، من أثاثها). وفي هذا السياق المشحون طائفيًا نشأت “سوقُ السُّنَّة” (هكذا بلا حياء)، ولا سيما في مدينة حمص، التي كانت تُباع فيها البضاعة المُعَفَّشة بأسعار بخسة. وهذا الاسم يدل على طائفتين تقفان على طرفي نقيض في الصراع الدائر: طائفة المُعَفِّشين وطائفة المُعَفَّش منهم. مع أنه، والحق يُقال، لم يقتصر المُعَفِّشون على أبناء الطائفة العلوية. فمع شيوع الفوضى وانفلات الوضع الأمني في سائر البلاد وتدهور الوضع المعيشي لمعظم السكان، انخرط أبناء كل الطوائف والفصائل المسلحة في تعفيش بيوت المُهَجَّرين والنازحين.
الجُمْلوكية
لم تَشِعْ مفردة “الجُمْلوكية” كثيرًا في أوساط السوريين، وربما لم يكن السوريون هم أول من أطلق هذا المسكوك اللفظي الطريف الذي نُحِتَ من كلمتين (الجُمهورية + المَلَكية) للدلالة على الطبيعة المتناقضة لنظام الحكم في سوريا (أنا سمعتها أول مرة من معلق سياسي على قناة الجزيرة). فنظام الحكم في سوريا، نظريًا ودستوريًا، نظام جمهوري، ولكنه عمليًا نظامٌ مَلَكيٌّ (أو جمهورية وراثية)، إذ يرثُ الابنُ الحكمَ من أبيه لا بإرادة الناخبين. وأعتقد أن عدم شيوع مصطلح “الجُمْلوكية” راجع إلى تراجع الحديث السياسي عن طبيعة نظام الحكم الأسدي والانشغال بالجرائم التي ارتكبها منذ بداية الثورة إلى سقوطه.
المِنْقَدَّسْلِية
هذا من المصطلحات النادرة التي لم تلقَ رواجًا شعبيًا في الحقيقة، ولكنه جدير بالذكر في هذا المقام لسببين في رأيي: أولًا، لطرافة اشتقاقه ومناسبته للحديث عن المُجتَرحات اللفظية السورية في القرن الحادي والعشرين استجابةً للظروف التي سادت بعد 2011؛ ثانيًا، لأنه، بخلاف المصطلحات الأخرى التي ذكرتُها في هذا المقال، صدرَ عن تيارٍ علويٍّ لا عن تيارٍ سُنِّيٍّ. وطريقة اشتقاق هذا المصطلح تشبه طريقة اشتقاق “المنحبكجي” (لذلك لا داعي للخوض فيها مرة أخرى) إلا أنه بدلاً من استخدام اللاحقة التركية “جي” استخدم مبتكر هذا المصطلح اللاحقة التركية الأخرى “لي” التي تقابل ياءَ النسبة في العربية – كما في قولهم “موصِلّلي” (نسبةً إلى الموصل) أو “لُبنانلي” (نسبةً إلى لبنان).
باختصار، المِنْقَدَّسْلِي شخصٌ يُقدِّس نظام الأسد ورموزه تقديسًا أعمى. وقد نشرت صفحةُ “البهلولية نيوز” على الفيسبُك مقالاً ساخرًا بعنوان “تيار اللحّيسة المِنْقَدَّسْلية” بتاريخ 15 شباط 2021 أنقله لكم أدناه بشيء من التصرف والاختصار، وقد أشرت إلى هذا المقال في مقالة سابقة لي بعنوان “أرباب الشعائر التطبيلية” نشرتُها على موقع تلفزيون سوريا. يُعرِّف كاتب المقال هذا التيار بأنه تيار افتراضي اجتماعي شبه سياسي وشبه منظم ظهر منذ سنة 2012، ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي. يُعدّ هذا التيار – السوري بامتياز – من أخطر التيارات الفيسبوكية على الإطلاق. من الممكن أن يكون هذا التيار موجَّهًا، وقد يكون غير موجَّه، يعني غالبًا أعضاؤه من اللحّيسة بالفطرة أو بالوراثة. مهمة هذا التيار:1) إقناع المواطن السوري – مهما كان فقيرًا أو محتاجًا أو جائعًا أو منهارًا أو مُغتَصَبًا أو موؤودًا أو ميتًا – أن كل ما يصدر عن الحكومة يصب في مصلحته ومصلحة عائلته؛ 2) أن كل ما يتعرض له من خوازيق ما هي إلا مؤامرات خارجية تحيكها القوى الرجعية والإمبريالية بهدف تدمير القوى الممانِعة والمقاومِة في الشرق الأوسط؛ 3) الدفاع عن كل مسؤول (حالي، سابق، متقاعد، ميت) صار حديثَ الفيسبُك، أو تعرض للنقد بسبب عمل فاسد قام به؛ 4) خلق إشاعات مضادة والترويج لها، والسعي لإقناع الشارع الفيسبوكي أن هذا المسؤول محل ثقة أو قامة وطنية أو شيخ وآدمي وصاحب دين، وأن كل ما قيل أو حِيك حوله ليس إلا إشاعات مغرضة تصب في مصلحة الكيان الصهيوني وعائلة روتشيلد.
أبو كلسون
عندما اقتحم الثوار المُنْتَشُون قصورَ بشار الأسد في دمشق وحلب بعد فراره إلى موسكو في 8 كانون الأول 2024، عثروا على مفاجأة صادمة: ألبومات صور يظهر فيها الدكتاتور الهارب مرتديًا ملابس داخلية فاضحة. وسُرعان ما انتشرت هذه الصور كالنار في الهشيم، وبين عشية وضحاها صار لقبُ الأسد لدى عامة الناس “أبو كلسون”. لم يُخْلَع الأسد من سلطته فحسب، بل جُرِّد أيضًا من آخر مظاهر الهيبة، ربما حتى في أعين أنصاره السابقين. لم تكن الصور مجرد فضيحة شخصية، بل تجسيدًا بصريًا لسقوط الطاغية وخوائه الداخلي. فقد تحطمت أسطورةُ الجبروت والهيبة، وانكشفت هشاشةُ رجلٍ حكمَ بالحديد والنار، لينتهي أضحوكةً في ذاكرة السوريين الجمعية.
التكويع
شاع مصطلح “التكويع” بعد سقوط نظام الأسد وفراره هو وكبار زبانيته من البلاد. هنا انكشف مؤيدو الأسد السابقون (من شَبِّيحةٍ ونَبِّيحةٍ ومِنْحِبَّكْجيةٍ ومِنْقَدَّسْليةٍ)، ولم يعد لديهم من يُطبِّلون له أو يرتكبون المجازر من أجله، وسُدُّت الحدودُ في وجوه الراغبين في الفرار. ومن أبرز المُكَوِّعين كان بشار الجعفري، سفير بشار الأسد في موسكو، والفنان المسرحي دريد لحَّام، وعضو مجلس الشعب السابق شريف شحادة. لكن لا بد من الإشارة إلى أن تكويع هؤلاء وغيرهم كان على درجات. فمن المُكَوِّعين من أعلن ولاءه لنظام الحكم الجديد بقيادة أحمد الشرع (كما فعل دريد لحَّام)، أو رضي بالعمل تحت قيادته (كما فعل بشار الجعفري الذي ظل يعمل سفيرًا لسوريا في موسكو إلى أن أُقيلَ من منصبه)، ومنهم من اكتفى بانتقاد بشار الأسد ونظامه (كما فعل شريف شحادة).
بقي أن أشرح أصل مصطلح التكويع. يشير الكوع في المصطلح العامي السوري إلى المنعطف في الطريق (أو U-Turn). وفي الاصطلاح السياسي السوري، يشير التكويع إلى التغير المفاجئ في موقف الموالين لبشار الأسد من النقيض إلى النقيض. وبعد شيوع المصطلح بأيام، اجترحتُ أيضًا ترجمةً إنجليزيةً موازيةً لهؤلاء المُكَوِّعين هي U-Turners!
هكذا أبدعت القريحةُ الشعبيةُ السوريةُ مصطلحاتٍ موجِعةً – شَبِّيح، مِنْحِبَّكجي، مُعَفِّش، مِنْقَدَّسْلي، أبو كلسون، مُكَوِّع – لم تُستعمل لأغراض الفرز السياسي فحسب، إنما لتكون أيضًا سلاحًا لفظيًا مُبدِعًا لوصف سلوكيات شائنة ارتكبتها فئةٌ من “شركاء الوطن” لا تتورع عن أي موبقة إرضاءً للطاغية، بل لا تتردد في تغيير مواقفها إذا انقلبت موازين الصراع لصالح المعارضة. لكن، هل ستحتفظ الذاكرة الجمعية السورية بأي من هذه المسكوكات اللفظية الطريفة أم سيتكفل الزمن بإحالتها إلى بطون الكتب والدراسات التاريخية والاجتماعية؟ إن مصير هذه المصطلحات ليس لغويًا فحسب، بل سياسي واجتماعي أيضًا. فبقاؤها أو اندثارها على المدى القريب مرهون بقدرة أطياف الشعب السوري كافةً على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة وتجاوز جراح الماضي.
تلفزيون سوريا