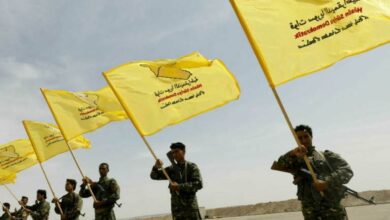الأزمة الطائفية وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الأسد/ أحمد عيشة

2025.05.24
انتقل الصراع في سوريا، بعد الخلاص من بشار الأسد، إلى صيغة جديدة تتمحور حول طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم الاقتصادي والسياسي.
لم يخرج الصراع هذا عن الجذور العقائدية/الأيديولوجية للمشتغلين في الشأن العام من تيارات سياسية، أو شخصيات مستقلة ومثقفين، ناهيك عن الأصوات المعبرة عن الطوائف، التي برزت مؤخراً بمجالسها وشيوخها وطغت على المشهد برمته، معبّرة عن وجهات نظر كانت مدفونة وكان التعبير عنها ممنوعًا.
ورغم التوافق الظاهري حول شكل الدولة بأنها مدنية تقوم على حق المواطنة وتمثيل الجميع، إلا أن ذلك التوافق كشف عن رؤى تفتيتية للبلاد، ونموذج تمييزي من المواطنة. بكلمات عامة، كانت المطالب تتركز حول امتيازات لجماعات عانت من الظلم، ولأخرى كي لا تتعرض للظلم، مما يُخفي كثيراً من المواقف الطائفية خلف ادعاءات بمعارضة طائفية السلطات الجديدة، كونها انبثقت عن تنظيم سلفي جهادي، في حين كان الصوت الوطني الديمقراطي هو الأضعف إن لم يكن غائبًا.
فرضت فرنسا، في إطار رؤيتها الاستعمارية، شكل الكيان السوري بما يتعارض مع تطلعات سكانه، بهدف تقسيم البلاد لضمان السيطرة، من خلال دويلات تقوم على أسس طائفية. بعد الاستقلال، اندفع أبناء الأرياف والأقليات الذين عانوا من التهميش لفترات طويلة لللالتحاق بالجيش وأيضاً بالأحزاب، وخاصة ذات المنحى الاشتراكي، حيث تمكنوا بعد سنوات من الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب 1963، الذي سيطر فيه حزب البعث على الحكم بدعم من لجنة عسكرية سرية معظم أعضائها من الأقليات، من بينهم حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة عام 1970، بعد صراع داخلي في الحزب، أنهى مرحلة من حكم يساري الشكل، وأسس دولة أمنية مركزية، وضع فيها أقاربه ومعارفه من الطائفة في مواقع حساسة، ومنح بعض السنّة مناصب شكلية دون سلطة فعلية، فخلق سلطتين: الأولى ذات تركيبة طائفية في الجيش والمخابرات وهي الحاكم الفعلي، والثانية شكلية تشمل الجميع، وهي واجهات لا أكثر.
باختصار، تحوّل النظام إلى حكم طائفي بواجهات “وطنية”، ما جعل بنيته طائفية وشكله “وطنيًا”.
لمحاولة فهم ما حدث ويحدث في سوريا، من الضروري تحديد مستويات الصراعات في البلاد، وهي متنوعة وذات أبعاد طبقية، وريف-مدينة، وطائفية، لكن الطابع المهيمن في سلطة الأسد هو الطائفي، الذي تجلى بتركيبة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المعارضين والثوار بطريقة تمييزية (عنف معمم في مناطق ومخصص في أخرى)، حيث خلق التعامل الوحشي ردات فعل طائفية مقابلة وساهم في تأسيس تيارات ذات نزعة طائفية أيضاً. إن تفسير كل ما جرى ويجري في سوريا وفق البعد الطائفي فقط غير كافٍ؛ فهو يوفر تفسيرًا أحاديًا لظاهرة معقدة لها جذور تاريخية عميقة. لذلك، لا بد قبل محاولة التفسير من توضيح بعض المفاهيم: ما هي الطائفية، وما هو الدور المحوري الذي لعبته في الصراع؟ من المهم أيضًا معرفة التركيبة الديموغرافية في سوريا لما لها من دور في فهم الصراع ككل.
الطائفية حسب برهان غليون “نتاج لغياب الدولة الوطنية الحديثة وفشل مشروع المواطنة”، وحسب عزمي بشارة: “استخدام سياسي للهويات الدينية في صراع المصالح”، فهي فعل سياسي للسلطات أو القوى المتصارعة على السلطة قائم على التعصب والتمييز والمصالح، يركز على الاختلافات المتخيّلة بين الجماعات الدينية ويجعل منها أساساً لخندقة تقوم على “نحن” و”هم”، و”هي”. بمعنى ما، تسعى الطائفية إلى تحويل الاختلافات إلى أساس لصراع وجودي: إما نحن أو هم، وتلغي إمكانية التفاهم بين الطرفين، وتدعو إلى أشكال من التطهير أو الإبادة.
لم يكن الصراع الطائفي جديداً في سوريا، فهو يعود لبدايات تشكل الكيان السوري، لكنه أصبح محوريًا في فترة الأسدية التي اعتمدت في حكمها على القوة العارية للجيش والمخابرات ذوي الهيمنة الطائفية، التي حولت سوريا ذات التنوع في تركيبتها السكانية إلى مصدر للانفجار والاقتتال بدل أن تكون مصدراً للقوة من خلال الاعتماد على قاعدة طائفية من جهة وتشجيع العداوات المتخيلة بين تلك الجماعات من جهة أخرى، مع العلم أن تلك الجماعات السكانية، وبغض النظر عن النسب، ليست كتلة صماء، وإنما تتباين في المواقف والمصالح وتخضع لتناقضات داخلية وصراعات مثلها مثل أي جماعة أخرى، يتشابك فيها الديني مع السياسي مع الاقتصادي (المصالح).
خلقت هذه الهيمنة مظالم كبرى، زادت من تأجيج الصراع، خاصة بعد الثورة وما شهدته من فظائع ارتكبها النظام بحق السوريين، إلى درجة أن الطائفية أصبحت خط الصدع الوحيد الذي يتمتع بسلطة فعّالة على الجميع. ورثت الإدارة الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام بلداً مدمراً يعاني من الفقر والتهميش والانقسامات الطائفية. وهي انقسامات عميقة يتأثر بها الجميع، يبدو الخلاص منها حتى على مستوى الخطاب أمرًا يحتاج إلى سنوات طويلة. وهذا يتطلب من الجميع وخاصة من السلطة بناء خطاب وممارسة دقيقتين، يركزان على خلق التقارب والوحدة بين مختلف الجماعات الإثنية والدينية، فمستقبل سوريا يكمن في القدرة على بناء هذا الخطاب والسلوك، كما أن الفشل في ذلك قد يدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة.
مثلت أحداث آذار في الساحل، وما تلاها من تطورات في السويداء وبعض مناطق ريف دمشق (جرمانا وأشرفية صحنايا)، الاشتباك الأول للخطاب السياسي مع حالة الانقسامات تلك، حيث أخذ شكلاً انفجارياً يعكس عمق الأزمة الطائفية. فالخطاب الذي تقدمه تلك الجماعات حول شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي كان خطاباً أيديولوجياً يسعى لتعبئة طائفية، ومحاولة للحفاظ على امتيازات قديمة أو خلق أخرى جديدة، مع نزعات تفتيتية، فلم يكن حديثهم عن دولة المواطنة سوى قناع زائف لمطالب أخرى. ونتيجة ربط النظام للطائفة بوجوده، بغض النظر عمّا إذا كان جميع أفرادها موافقين أو مستفيدين، وفي ظل غياب صوت جماعي يرفض الفظائع التي ارتُكبت خلال الثورة (رغم وجود أصوات فردية معارضة)، وجد العلويون أنفسهم محاصرين بين مطرقة الانتقام وسندان النظام، وضحايا لتلك السياسة.
يتفق معظم السوريين، في الخطاب، على قيام دولة قانون تحقق الكرامة والحرية، لكن تظهر التناقضات والصراعات حول مضمون هذه الدولة وطريقة تحقيقها، ما يكشف عن عمق الجذور الطائفية التي تغلف الممارسة السياسية والمصالح الضيقة وتفقدها مصداقيتها. ومن جانب آخر، يظهر ضعف بنية الجماعات السياسية. كان غياب صوت العقل والنقد الموضوعي هو السائد، باستثناء بعض الأصوات الفردية، حيث غابت السياسة بمعناها الحقيقي كصراع وتسويات بين قوى اجتماعية، وتحولت إلى اشتراطات وطلبات واجبة التنفيذ.
أمام هذه التركيبة والصدوع العميقة، يبقى المخرج الوحيد هو العمل على بناء دولة من خلال تأسيس جيش وقوات أمن على أسس وطنية مهنية، تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري. دولة تعمل على بناء هوية وطنية سورية تقوم على المواطنة التي تساوي بين الجميع، وتخلص البلاد من منطق الأكثرية والأقلية القائم، دون تمييز لجماعة على أخرى تحت ذريعة حماية الأقليات كما يطالب البعض في الداخل والخارج، وتقوم على نظام يعتمد التنوع السياسي أولاً، الذي يضمن سلامة التنوع الثقافي والاجتماعي لا العكس، ويكفل مشاركة عادلة للجميع، وأولى تلك الخطواب بناء جيش وقوات أمن على أسس وطنية، وهو انجاز هائل إن تمكنت الحكومة الجديدة من تحقيقه، إضافة للتخلص من المناهج التعليمية المتعددة ذات الصبغة الأيديولوجية، والاهتمام بمسألة العدالة الانتقالية من خلال محاسبة رمزية أو فعلية على الجرائم والانتهاكات.
ويبقى في النهاية القول إن فهم الأزمة السورية من منظور طائفي فقط هو فهم تبسيطي، يتجاهل تعقيدات أخرى مثل: الصراعات الاجتماعية البينية، والقوى الخارجية ونزعات الهيمنة لديها، والنظم السلطوية. فالطائفية ليست سوى واحدة من أدوات التدمير لدى القوى المهيمنة، كما أن الخلاص منها هو عملية سياسية بامتياز، طويلة الأمد، تبقي على التنوع في إطار الوحدة، فمصدر قوة البلدان اليوم تنوعها، ومستوى الحرية فيها.
تلفزيون سوريا