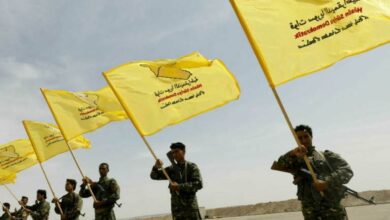عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 25 أيار 2025

لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
—————————
التعافي من تركة الآثام/ محمد برو
2025.05.25
على مدى أربع وخمسين سنة حكم الأسد الأب والابن سوريا بقبضة حديدية، وممارسة أمنية أشبه ما تكون بالكلاب المسعورة، في تتبع أدق الزوايا في الحياة السورية وتهشيمها، وإعادة صياغتها على نحو يخدم الاستبداد والحاكم الفرد. لم تستثن هذه الملاحقات الستالينية أي منحى من مناحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، وبدأت في تشكيل الأشواه التي تخدم سلطتها منذ سني الطفولة الأولى، مرورا بسنوات الشبيبة واتحادات الطلبة وهلم جرى، وجعلت الفساد والمنظومة المبررة له أو المشرعنة له جزء من الثقافة اليومية للعامة والخاصة، كما أنتجت لغة ومفردات ما أن تسمعها حتى تعلم أنك تكرر سماع ما سمعته آلاف المرات، دون أن يكون له أي معنى أو دلالة سوى استغباء السامعين ودفعهم لطأطأت الرؤوس ورفع الأيدي بالقبول، علاوة على كل ما سلف جرى تدمير للقيم الاجتماعية التي تشكل في لحظات الضعف سندا وداعما، تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحول دون الانهيار الكارثي السريع، كما حدث في المجتمع السوري بكافة طبقاته وشرائحه، وبات التفسخ الاجتماعي وانهيار منظومة الأسرة وفقد الثقة والأمان العامين، السمة الظاهرة في هذا المجتمع المدمر، الذي فتكت به الفاقة والعوز أشد الفتك.
واليوم وبعد سقوط هذا النظام ورحيل رموزه الكبيرة، تسرب الوهم إلى بعضنا أننا أنهينا بكفاح مرير حقبة سوداء من تاريخ سوريا، وأننا في تشوف كبير لبناء سوريا جديدة مختلفة بالكلية عن سوريا الضحية، غافلين أو متغافلين أن تلك النبتة الخبيثة التي زرعها نظام الأسدين، أنتجت بذورا وأبواغا وطبعت نفوسا، وكرست أنماطا من الممارسات ربما نحتاج لعقود كي نكون متعافين من عقابيلها، فخلال مئات الحوارات والمتابعات تجدنا ما أن تعترضنا عقدة أو عقبة، حتى يسارع مخزوننا الأسدي المتراكم عبر ما ينوف عن خمسين سنة، ليقترح الأنماط المخزونة من تلك الحلول التي سادت في تلك الأيام المنصرمة ( توسط لدى مسؤول دفع مبالغ تفتح الأقفال، اللجوء إلى احتيال قانوني يمرر الممنوع، التهديد بالقوة وممارسة العنف) حتى في انتقاد الفوضويين أو المعارضين الذين يهددون استقرار البلاد اليوم، تتكرر ذات العبارات التي كانت سائدة خلال العقود السابقة، في تجريمهم ووسمهم بالخيانة والعمالة وما لا يحصى من أدوات القتل والإقصاء اللفظي.
في فترة حكم الأسدين عمل النظام ونجح، في تكريس انقسامات طائفية ما تزال إلى هذه الساعة من أقوى محرضات النزاع وتأجيجه واحالة الكثير من الأزمات إليه، سيما أن بعضها مثقل بحمولات ثأرية لانتهاكات وجرائم ارتكبت على مدى عشرات السنين، وارتفعت وتيرتها بمذابح ومجازر شنيعة خلال العقدين الأخيرين، وهذا يدخل البلاد فيما يسمى بالحلقة المعيبة التي يدور السالك أو الغارق فيها دون القدرة على التوقف أو التقاط نقطة البداية والنهاية، ولا بد هنا من اجتراح فعل استثنائي يتجاوز منطق الحق والعدالة ويرتفع عنهما، لإيقاف دوامات الكراهية والعنف والتخندق الضيق، ولن ترضي هذه الحلول الاستثنائية الشطر الأكبر من المتضررين، لكن لا بد من التضحيات في طريق الصعود من الهاوية، ولن يجري الانتقال من بيئة الشحن الطائفي واستدعاء حوادثها السابقة، وما تستلزمه من مشاعر عدوانية تثوي تحت جلود الكثيرين منا، بمجرد التنديد بها أو إدانتها.
هناك طريق طويل وشاق سلكته أمم قبلنا حتى ترسخت لديها معايير المواطنة والاحتكام إلى القانون الذي يساوي بين الجميع، صحيح أن هذا الحلم لم ينجز على نحو تام لا في الشرق ولا في الغرب، لكن شعوبا واسعة باتت اليوم تعيش الشطر الأكبر من هذا الإنجاز، يتطلب هذا التحول العميق والطويل إرادة عنيدة من السلطات الحاكمة والاتجاهات الثقافية والمؤسسات التربوية والإعلامية، ونحن نشهد اليوم مدى قوة التأثير التي تمتلكها الدراما وسائر الأدوات الفنية في خلق اتجاهات ثقافية تلهب الشباب وتدفعهم للتماهي بها.
هكذا تنتصب أمانا اليوم أصنام لثلاثي الشر، “التخندق الطائفي أو الإثني، الفساد الذي أصبح جزء من منطق وطبيعة الأشياء، شبح الانتقام لمئات آلاف الضحايا الذين ينتظرون العدالة الغائبة وربما تكون المستحيلة” في لحظة تحاول فيها سوريا الجديدة ان تنهض من مستنقعات تركة الآثام التي يصعب حصرها أو النجاة من دماملها المتقيحة، هذا ونحن نضرب في حديثنا صفحا عن التركة الكارثية للآثار الاقتصادية التي سيدفع سائر السوريين ثمنها عقودا في ترميمها والخلاص من تبعاتها.
وإذا أوغلنا قليلا سنجد صحارى سوداء من الآثار النفسية المدمرة، التي يكاد ينجو منها النذر اليسير، والتي ستطبع أرواحهم لسنوات طويلة، فقد شكل النزوح المستمر والتهجير والاعتقال ودوامات العنف شعورا جمعيا عميقا بالخوف والرعب المهيمن، حتى على عالم أحلامنا، وتضاعفت حدة الاكتئاب عند الشريحة الأوسع، وبات نمط اللامنتمي الهروبي والانعزالي والظواهر الانسحابية سمة مألوفة ومفهومة عند الكثيرين، وأصبح القلق والسوداوية والاغتراب الاجتماعي وفقدان الأمل، سمة مشتركة وسائدة.
عملت راوندا وجنوب إفريقيا ودولة المغرب على آليات مستحدثة، للتعافي من الآثار الاجتماعية والنفسية لدى مجتمع أنهكته الحروب والأزمات وحكم الفرد المستبد، من خلال لجان الحقيقة والمصالحة ومن خلال منصات للضحايا والشهود ولجان الاعتراف بالحقيقة وطلب الصفح والمسامحة، أيضا محاكم مجتمعية “غوتشا” في راوندا، وهناك بلدان أخرى اجترحت حلولا أو مسارات خففت من جراحات الماضي، وتركت الباب مفتوحا أمام فرصة مجتمعية واسعة للنجاة من عبئ الجرائم وعبئ الاقتصاص من المجرمين، وقدمت في تلك التجارب نماذج ناجحة في تغليب المصلحة العامة على الحق الشخصي، لكن هذا لم يحدث عنوة أو جبرا بل جرت حوارات وتواطأت اتجاهات وقوى وطنية ومثقفون وقادة رأي، على جعلها أقل الحلول ضررا على مستقبل البلاد وأهلها.
ولليونان وإسبانيا تجارب مختلفة وناجحة في التعافي من آثار الحكم العسكري والملكية، ولن يكون بإمكان السوريين تقليد أي نموذج من هذه النماذج الآنفة، بل إن النماذج الآنفة الذكر لم تكن تقليدا لنماذج وتجارب سبقتها، بل هي ابتداع صرف تمليه طبيعة الأزمة وطبيعة السكان الخاصة والظرف الزمني ومحصلات القوى اللاعبة في هذه الساحة، واستعداد الناس وقابليتهم للانسجام مع هذه الحلول، وهكذا سيكون الأمر لدى السوريين، ستكون هناك حلول تنبعث من رحم الواقع وخصوصية الأزمات، تلبي الاتجاه العام والمطلوب للخروج من مستنقع الدوامات، وتكسر مساراتها الصعبة. ستكون الشجاعة المفرطة باقتراح الحلول بمواجهة المنطق السائد للعدالة وحقوق الضحايا، سيكون هناك خلاف وربما صراع طويل لترجيح أحدهما على الآخر، وستكون الحلول جميعها منقوصة ومعتلة ومفرطة بحقوق جانب من المصلحة لتحقيق جوانب أخرى، ولا مناص من البدء واتخاذ القرارات الشجاعة والعمل على خلق ثقافة قبول وتفهم لها، وإلا سنجتر آلامنا وحقوقنا المؤجلة وسنبقى في صراع طويل بين أحقية الأمن والسلام أو أحقية إنفاذ العدالة.
تلفزيون سوريا
—————————-
الساحل السوري… سقط النظام فتزايدت الهجرة!/ كمال شاهين
“لو بقينا هنا، سنكون إما جثثاً في أخبار عاجلة، أو أطباء بلا دوامٍ أو أدوية”، هذا ما يقوله الطالب في كليه الطب من مدينة بانياس، أحمد زاهر، في هذا التحقيق الذي يسلّط الضوء على تزايد أعداد الساعين إلى الهجرة في الساحل السوري، من دون أن تكون المجازر الأخيرة السبب الوحيد، بل تضاف إليها أسباب أخرى اقتصادية اجتماعية في ساحلٍ لم يعد يتعرّف على هويته.
22 أيار 2025
(الساحل السوري). “كل ليلة، أضع رأسي على الوسادة وأسأل نفسي: هل أموت غداً برصاصٍ عشوائي، أم أخاطر بركوب البحر لأموت غرقاً؟”. يقول ياسر زاهر (25 عاماً) الذي فقد ثلاثة أصدقاء في مجازر في منطقة بارمايا في ريف بانياس.
السؤال نفسه، يطرحه بصيغةٍ أخرى خرّيجُ كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة تشرين تمام (24 عاماً)، قائلًا لحكاية ما انحكت: “بعد كل ما حدث، لم يعد السؤال هل نغادر؟ بل متى نغادر؟”. يقول ذلك وهو يبحث ضمن مجموعةٍ على تيليغرام، اتفق مع مجموعةٍ من أصدقائه على وضع كلّ أخبار الهجرة فيها. المفارقة أنّ تمام ينتمي إلى جيل كان يُفترض أن يحتفل بـ”سقوط النظام”، لكنه اليوم يجد نفسه، وفي ظلّ أجواء مشحونةٍ بالخوف وعدم الاستقرار والإشاعات اليومية، أمام سؤال: لماذا تتفاقم أحلام الهجرة في الساحل رغم زوال نظام الأسد؟
وكما حدث قبل أربعة عشر عاماً عندما ملأ سوريون آخرون القوارب والمخيّمات والسفارات بحثاً عن فرص للنجاة، فإنّ هناك اليوم من ينتظر دوره في قوارب ومخيّماتٍ جديدة. من بين هؤلاء آلافٌ من سكان الساحل السوري لا يفكرون اليوم سوى في الهجرة للنجاة بأرواحهم وسط مستقبلٍ مظلم بدل انتظار موتٍ مجاني. هذه المرّة تبدو ضرورة الهجرة أمراً وجودياً تُغذيه الدوافع الاقتصادية والاجتماعية أيضا، لأنه “لو بقينا هنا، سنكون إما جثثاً في أخبار عاجلة، أو أطباء بلا دوام أو أدوية”، كما يقول الطالب في كليه الطب من مدينة بانياس، أحمد زاهر، مستعيداً بعض صور زملائه من الطائفة العلوية في حي القصور: “قُتل ما لا يقل عن عشرين طبيباً في الأسبوع الأسود في بانياس ومعهم عشرات المعلمين والطلاب، واختفى عددٌ غير معروف منهم. ليس من المعقول أبداً أن تعجز السلطة الحالية عن ضبط الأمن والأمان، مطلب الناس الأساسي، بسبب انفلات عناصر منتمين إلى أجهزتها كما تدّعي. الأسوأ من هذا أنّ الأمر نفسه قد يتكرّر لأيّ سببٍ سياسيٍّ أو عسكري لا دخل لنا به”. فيما يشرح الشاب، علي عيسى، من بلدة القرداحة وهو يعمل في قطاع التعليم كإداريّ قائلا: “هذه الأزمة الوجودية تدفع الكثيرين إلى البحث عن مكانٍ يمكنهم فيه إعادة تعريف هويتهم بعيداً عن سوريا التي لم تعد كما عرفوها، ولا كما حلموا بها”.
وهكذا أدّى التصاعد المتكرّر للتوتّرات الأمنية، وتهديدات النزوح الداخلي التي شهدت تزايداً كبيراً بعد مجازر السادس من آذار/ مارس وما تلاها ضمن مناطق مختلفة من الساحل السوري من استمرار ممارسات القتل والخطف، إضافة إلى غياب الجهات الأمنية الضامنة لأبسط حقوق الناس في التنقّل والعمل، إلى إعادة حلمٍ قديمٍ مؤلمٍ إلى الواجهة: الهجرة والسفر والخروج من البلد بأيّة وسيلة، وهذه المرّة من الساحل السوري الذي لم يتوقف نزيف أبنائه حتى الساعة. وهو ما تؤكّده الوقائع، حيث “انتشلت سلطات الإنقاذ في قبرص جثث سبعة أشخاص، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى الجزيرة، بعد أن انطلقوا على متن قارب من محافظة طرطوس يتوقع أنه كان يحمل على متنه 20 شخصاً” وفق تقرير نشرته القدس العربي. وليس بعيداً عن هذا الخبر، يتيح العبور أمام مبنى الهجرة والجوازات في اللاذقية أو طرطوس مشاهدة مئات الأفراد ممن ينتظرون دورهم للحصول على جواز سفر بتكلفةٍ ليست قليلة. هؤلاء المئات ليسوا أبناء طائفةٍ واحدة. إنهم سوريون يطرقون أبواب العالم من جديد بحثاً عن نجاةٍ يبدو احتمالها ضعيفاً هذه المرّة.
بعد سقوط النظام.. لا أمان، ومجازر، وانهيارٌ اقتصادي، وأفقٌ مجهول
اللاذقية، التي كانت تُعتبر آمنةً نسبياً، لم تعد كذلك. فمنذ مجازر الساحل في مطلع أذار/ مارس لم تتوقف الانتهاكات. في الأيام العشرة الأولى من شهر نيسان أبريل ٢٠٢٥، سقط ما لا يقل عن 26 شخصاً في سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في مقاهيها، التي كانت تعجّ بحديث الثورة والمستقبل، بات الحوار اليومي يدور حول كيفية مغادرة البلاد. يقول مشغّل أحد مقاهي منطقة الزراعة، قيس حاتم (أربعون عاماً): “المفارقة أنّ سقوط النظام، الذي كان يُفترض أن يُنهي أسباب الهجرة، زاد الطين بلّة. تحت أنقاض الحرب، برزت فجواتٌ جديدة تدفع الشباب إلى حزم حقائبهم: قلقٌ أمنيٌّ متجدّد مع كلّ تحركٍ لقوات الأمن أو الفصائل التي لا يضبطها شيء ولا قانون يردعها، يُضاف إليه قلقٌ يوميّ مع كلّ خبرٍ عن احتمال قصفٍ إسرائيليّ على مواقع عسكرية مثل موقع سقوبين الملاصق للّاذقية التي تضم عشرات آلاف السكان، وطائفيةٌ خفية ومعلنة تظهر في أبسط التفاعلات اليومية، واقتصادٌ منهار حوّل الشهادات الجامعية إلى مجرّد أوراق لا تساوي ثمن تأشيرة السفر”.
“كنا نظن أنّ التغيير سيأتي بالحرية، لكنه جاء بفوضى لا نعرف كيف نتعايش معها”، يعترف مهندسٌ شاب في الخامسة والعشرين من عمره يعمل في مرفأ اللاذقية (طلب عدم ذكر اسمه) كان من أشدّ المؤيدين للثورة، التقيناه في المقهى نفسه: “في مؤسسات الدولة هناك كآبةٌ واضحة في المعاملات والتعاملات اليومية. وهناك تخبّطٌ إداري كبير. مؤسساتٌ تدار بعقلية النهب”.
هذا التحوّل من “الهروب من النظام” إلى “الهروب من كل شيء” يفسّر لماذا صارت مقاهي الجامعات أشبه بوكالات سفرٍ غير رسمية، ولماذا تحوّلت أحاديث الأصدقاء من السياسة إلى مقارنة أسعار تأشيرات الدول. يقول المهندس “تمام” من قرية الشلفاطية التي شهدت مجازر طائفية إنّ “الساحل الذي وقف أهله مع التغيير في سوريا يجد نفسه اليوم أمام معضلةٍ وجودية، البقاء يعني العيش على هامش التاريخ، والمغادرة تعني الاعتراف بأن كل التضحيات ذهبت سدى”.
“نحن لسنا على خط نارٍ مباشر، لكننا نعيش احتمال اشتعال النيران كلّ يوم”. هذا ما تصفه الطالبة في كلية الطب سنة ثالثة، من مدينة بانياس لينا ابراهيم، مضيفةً: “على رغم أنّ الجامعات لم تتحوّل إلى ساحات قتال، إلا أنّ القصف الإسرائيلي المتكرّر على مواقع مثل المينة البيضا (شمال اللاذقية)، وتصاعد عمليات الاغتيال والاشتباكات في المناطق المحيطة (مثل جريمة دوار الأزهري وغيرها كل يوم)، أعادا تشكيل مفهوم (الأمان) في ذهن السوريين في الساحل السوري. الخوف من التصعيد المفاجئ صار كافياً لجعل فكرة الاستقرار مستحيلة”.
حتى لو تجاوز الطالب مخاطر العنف والتمييز، فإنّ السؤال الأكبر: ماذا بعد التخرّج؟ “حصلتُ على شهادة الصيدلة قبل عامين، وأعمل اليوم في مستودع أدويةٍ براتب لا يتجاوز مئة دولار شهرياً”، يقول كريم مغيروني (25 عاماً) من مدينة اللاذقية. ويتابع كريم: “العنف الطائفي، الفوضى الأمنية، والانهيار الاقتصادي حوّلت (النصر) إلى كابوسٍ يومي. هذه العوامل لم تدفع الشباب إلى حزم حقائبهم فحسب، بل حولت الهجرة من (خيار) إلى (ضرورة جماعية)”.
الهوية المفقودة… الساحل السوري غريبٌ عن أهله
في شوارع الساحل التي كانت تعجّ بحياة مختلفة قبل عدّة شهور، تسير خريجة الهندسة سارة فندي من جبلة (25 عاماً)، وهي لا تعمل الآن، تقبع في انتظار قرار تعيين في وظيفةٍ حكوميّة قد لا يأتي أبداً وإلى جوارها يمشي جيلٌ لا يحلم إلا في الهجرة. تقول سارة: “كل يوم يمرّ أشعر أن مدينتي تبتعد عني أكثر. الأماكن نفسها، لكن الروح تغيّرت”.
هذا التحوّل في الهوية الجماعية للساحل السوري أصبح دافعاً خفيّاً يُضاف إلى أسباب الهجرة. يشرح الشاب علي عيسى من بلدة القرداحة، وهو يعمل في قطاع التعليم كإداريّ: “الشباب الذين عاشوا سنوات الحرب يحملون ذكرياتٍ عن ساحل مختلف، منفتحٍ على العالم وعلى السوريين ككل، ليس كما كان في عهد الأسد، وليس كما صار بعده. إنهم يعانون من اغترابٍ مضاعف، عن الماضي الذي لم يعودوا يريدونه، وعن الحاضر الذي لم يختاروه. نحن لسنا ضحايا نظام فقط، بل ضحايا تحوّلٍ لم نكن نتخيّله”.
اليوم، هناك اكتشافٌ للهويات الطائفية لدى كثيرين من جيل الشباب. يقول “علي”: “لا أعرف ما هي الحصيلة التي ينالها من يسألك على الطالعة والنازلة عن طائفتك؟ ماذا تقدّم له هذه المعلومة؟ إذا جنّ ربعك عقلك ما ينفعك لذلك إذا كان فيك تغادر، ضب شناتيك ولا تقصر”.
“في الكلية، لم نكن نسأل بعضنا عن الطوائف”، تتذكر الطالبة في كلية الصيدلة من مدينة طرطوس رنا سليمان، وتتابع: “اليوم صار السؤال الأول الذي تواجهه عند التعارف هو السؤال الطائفيّ علناً أو خفيةً”. هذا التحوّل المفاجئ في الأولويات الاجتماعية يضع الشباب أمام معضلةٍ وجودية: كيف يحافظون على هويتهم المدنيّة في ظل تصاعد الخطاب الطائفي؟ “كنت أعتقد أنني سوريّةٌ أولاً”، تقول رنا، “لكن الأحداث الأخيرة أجبرتني على إعادة النظر حتى في طريقة كلامي”.
“الثورة كانت تعني الحرية، لكن (الحرية) التي جاءت بعد سقوط النظام صارت أكثر الأشياء التي نخاف منها”، تعترف رنا، وتتابع “ففي ظلّ انعدام القانون، صارت (الحرية) تعني حرية الميليشيات في التحرّك، وحرية الأقوى في فرض إرادته. هذه المفارقة تدفع الكثيرين إلى مفارقةٍ أخرى: الحنين إلى زمنٍ كان القمع فيه على الأقل منظّماً ومتوقعاً”.
هذه الطبقات المتعدّدة من الاغتراب تخلق شعوراً جماعياً بالتشظي. “كأننا نعيش في مدينةٍ شبحية، كلّ شيء فيها يذكرنا بما كان ولم يعد”، تصف “نورا” (22 عاماً) ابنة جبلة من الطائفة السنيّة وهي تعمل في محلّ تجميل. هناك انقسامٌ واضح في العلاقات الجماعية. وتتابع: “كلّ طائفة تعيش ضمن حدود حاراتها، وما إن يحل الليل حتى نعود إلى بيوتنا ونغلق الأبواب والشبابيك خوفاً من المجهول. هذه الأزمة الوجودية، الأعمق من كلّ المشكلات المادية، قد تكون الدافع الأقوى الذي يدفع أقدام الشباب نحو المجهول، إذ أنه من المحتمل أن يسألك فصيلٌ مسلح عن طائفتك وترتبك في الإجابة، أو لا تريد الإجابة، فيكون مصيرك بضع طلقاتٍ في الرأس. هذا ما حدث في جبلة عدّة مرات بعد مجازر السادس من آذار”.
بين أحلام الهجرة وإمكانية تطبيقها
تلعب تكلفة السفر والمكان المقصود دوراً كبيراً في حدّ كثيرين عن التفكير بالسفر. يقول المحامي علي غانم (في أواخر ثلاثينياته) من اللاذقية في حوارٍ معه إنّه جرّب التقديم على اللجوء الإنساني في البرازيل عبر موقعٍ الكتروني فاكتشف أنّ الشيء الوحيد المجانيّ هو الإقامة في البرازيل، في حين أن “تكلفة السفر والأوراق والإقامة الفندقية الحصرية جميعها عليه، وتبلغ في الحدّ الأدنى ثلاثة آلاف دولار تعادل راتب موظفٍ حكوميّ لمدة ستين شهراً، وهذا يعني الحاجة إلى بيع أصول مادية مثل البيوت والسيارات في حال توفرها ولكن سوق العقارات في أسوأ أحواله ومثله سوق السيارات التي تهاوت أسعارها كثيراً”.
يرى علي أنّ قلّةً قليلة من الناس يمكنها أن تغامر بالسفر إلى بلدٍ بعيد كالبرازيل من دون وجود احتمال عقد عمل وهذا يصح على فردٍ واحد فما بالك بأسرة؟ ويضيف: “عموم أهل الساحل فقراء ليس لديهم شيءٌ من هذا المبلغ في ظلّ فصل آلاف الموظفين من أعمالهم واختفاء آلاف الأعمال. في واقع الأمر، مَن أراد السفر من الأغنياء فعل ذلك قبل وقتٍ طويلٍ من سقوط النظام، هذه الحسابات المادية تخلق طبقةً جديدةً من المهمّشين: أولئك الذين يريدون الهجرة لكنهم محبوسون في وطنٍ لم يعودوا يعترفون به”.
هذه المعادلة القاسية تخلق فجوةً هائلة بين الرغبة في الهجرة والقدرة عليها. فبينما يزداد عدد الراغبين بالمغادرة يومياً، تتحوّل الهجرة إلى امتيازٍ طبقيّ. “الأسر التي تمتلك شبكة علاقاتٍ في الخارج، سواءٌ عبر مغتربين يرسلون الأموال أو معارف يسهلون الإجراءات، هي وحدها القادرة على عبور هذه الهوة. أما البقية، فيجدون أنفسهم محاصرين في دوامةٍ من الحلول المستحيلة” يقول علي متابعاً حديثه معنا.
البعض يحاول ركوب البحر من رأس البسيط إلى قبرص، رغم أنّ تكلفته تصل إلى ألفي دولار ومخاطره لا تُحصى. “أعرف عائلاتٍ باعت كل ما تملك لتمويل رحلةٍ واحدة لابنها، أما اللجوء إلى الهجرة الداخلية، أي إلى المدن السورية الأخرى فهو غير ممكن في الساحل السوري أساساً بسبب الحمولات الطائفية الكبيرة التي تتفجّر في البلد. في دمشق تعمل عائلاتٌ كثيرة من الساحل السوري على العودة إلى قراها ومدنها الساحلية حيث لا يتوفّر أيّ نوعٍ من الأعمال ولا الآمال. فعلياً، ومن دون أيّة مبالغة، في بعض القرى الساحلية، لم يبقَ سوى كبار السن والأطفال، وهؤلاء يشكلون لوحةً كئيبةً لمستقبل مجتمعٍ يفقد مقومات بقائه الأساسية يوماً بعد يوم” تقول منى حويجة، عاملة إغاثة من اللاذقية.
في المقابل، تظهر فئةٌ جديدة من “المحاصَرين”، أولئك الذين تمكنوا من جمع المال لكنهم عاجزون عن المغادرة بسبب تعقيدات الإجراءات أو نقص الوثائق أو مشاكل الفيزا. يقول طالبٌ في كلية الهندسة، كريم إبراهيم، من طرطوس: “تمتنع كثيرٌ من الدول اليوم عن منح السوريين فيزا نظامية للدخول بعد عشر سنوات من تدفق السوريين حول العالم. لقد حصلتُ على منحةٍ دراسية في الولايات المتحدة لكنني عالقٌ هنا منذ عامٍ تقريباً لأنّ الحكومة الأميركية لم تقرر حتى الآن منحي الفيزا”.
الأكثر إيلاماً أن هذه العقبات لا تُوقِف تدفق الراغبين بالهجرة، بل تدفعهم إلى خياراتٍ أكثر خطورة. أحاديث محلية تتحدّث عن ظهور “سماسرة هجرة” يقدمون عروضاً ووعوداً كاذبة بطرق غير شرعية سبق للسوريين أن جرّبوها في العديد من سنواتهم. “يبيعون الناس أوهاماً، وينتهي الأمر ببعضهم في السجون أو في قاع البحر”، كما يقول كريم.
هكذا، في ظلّ غياب أيّة حلول مؤسساتيةٍ من النظام الجديد في سوريا أو حتى طرحها، وغياب أيّة برامج دعم دولية، يصبح الساحل السوري سجناً مفتوحاً لمعظم أهله. الأغنياء غادروا، والفقراء يحلمون بالخلاص، والطبقة الوسطى تتآكل يومياً بين ارتفاع التكاليف وغياب أي أمل. السؤال لم يعد: لماذا تهاجر؟، بل كيف تفعل ذلك إن كنت من المحظوظين القلائل الذين يستطيعون؟
صحفي وكاتب سوري
حكاية ما انحكت
——————————
الأزمة الطائفية وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الأسد/ أحمد عيشة
2025.05.24
انتقل الصراع في سوريا، بعد الخلاص من بشار الأسد، إلى صيغة جديدة تتمحور حول طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم الاقتصادي والسياسي.
لم يخرج الصراع هذا عن الجذور العقائدية/الأيديولوجية للمشتغلين في الشأن العام من تيارات سياسية، أو شخصيات مستقلة ومثقفين، ناهيك عن الأصوات المعبرة عن الطوائف، التي برزت مؤخراً بمجالسها وشيوخها وطغت على المشهد برمته، معبّرة عن وجهات نظر كانت مدفونة وكان التعبير عنها ممنوعًا.
ورغم التوافق الظاهري حول شكل الدولة بأنها مدنية تقوم على حق المواطنة وتمثيل الجميع، إلا أن ذلك التوافق كشف عن رؤى تفتيتية للبلاد، ونموذج تمييزي من المواطنة. بكلمات عامة، كانت المطالب تتركز حول امتيازات لجماعات عانت من الظلم، ولأخرى كي لا تتعرض للظلم، مما يُخفي كثيراً من المواقف الطائفية خلف ادعاءات بمعارضة طائفية السلطات الجديدة، كونها انبثقت عن تنظيم سلفي جهادي، في حين كان الصوت الوطني الديمقراطي هو الأضعف إن لم يكن غائبًا.
فرضت فرنسا، في إطار رؤيتها الاستعمارية، شكل الكيان السوري بما يتعارض مع تطلعات سكانه، بهدف تقسيم البلاد لضمان السيطرة، من خلال دويلات تقوم على أسس طائفية. بعد الاستقلال، اندفع أبناء الأرياف والأقليات الذين عانوا من التهميش لفترات طويلة لللالتحاق بالجيش وأيضاً بالأحزاب، وخاصة ذات المنحى الاشتراكي، حيث تمكنوا بعد سنوات من الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب 1963، الذي سيطر فيه حزب البعث على الحكم بدعم من لجنة عسكرية سرية معظم أعضائها من الأقليات، من بينهم حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة عام 1970، بعد صراع داخلي في الحزب، أنهى مرحلة من حكم يساري الشكل، وأسس دولة أمنية مركزية، وضع فيها أقاربه ومعارفه من الطائفة في مواقع حساسة، ومنح بعض السنّة مناصب شكلية دون سلطة فعلية، فخلق سلطتين: الأولى ذات تركيبة طائفية في الجيش والمخابرات وهي الحاكم الفعلي، والثانية شكلية تشمل الجميع، وهي واجهات لا أكثر.
باختصار، تحوّل النظام إلى حكم طائفي بواجهات “وطنية”، ما جعل بنيته طائفية وشكله “وطنيًا”.
لمحاولة فهم ما حدث ويحدث في سوريا، من الضروري تحديد مستويات الصراعات في البلاد، وهي متنوعة وذات أبعاد طبقية، وريف-مدينة، وطائفية، لكن الطابع المهيمن في سلطة الأسد هو الطائفي، الذي تجلى بتركيبة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المعارضين والثوار بطريقة تمييزية (عنف معمم في مناطق ومخصص في أخرى)، حيث خلق التعامل الوحشي ردات فعل طائفية مقابلة وساهم في تأسيس تيارات ذات نزعة طائفية أيضاً. إن تفسير كل ما جرى ويجري في سوريا وفق البعد الطائفي فقط غير كافٍ؛ فهو يوفر تفسيرًا أحاديًا لظاهرة معقدة لها جذور تاريخية عميقة. لذلك، لا بد قبل محاولة التفسير من توضيح بعض المفاهيم: ما هي الطائفية، وما هو الدور المحوري الذي لعبته في الصراع؟ من المهم أيضًا معرفة التركيبة الديموغرافية في سوريا لما لها من دور في فهم الصراع ككل.
الطائفية حسب برهان غليون “نتاج لغياب الدولة الوطنية الحديثة وفشل مشروع المواطنة”، وحسب عزمي بشارة: “استخدام سياسي للهويات الدينية في صراع المصالح”، فهي فعل سياسي للسلطات أو القوى المتصارعة على السلطة قائم على التعصب والتمييز والمصالح، يركز على الاختلافات المتخيّلة بين الجماعات الدينية ويجعل منها أساساً لخندقة تقوم على “نحن” و”هم”، و”هي”. بمعنى ما، تسعى الطائفية إلى تحويل الاختلافات إلى أساس لصراع وجودي: إما نحن أو هم، وتلغي إمكانية التفاهم بين الطرفين، وتدعو إلى أشكال من التطهير أو الإبادة.
لم يكن الصراع الطائفي جديداً في سوريا، فهو يعود لبدايات تشكل الكيان السوري، لكنه أصبح محوريًا في فترة الأسدية التي اعتمدت في حكمها على القوة العارية للجيش والمخابرات ذوي الهيمنة الطائفية، التي حولت سوريا ذات التنوع في تركيبتها السكانية إلى مصدر للانفجار والاقتتال بدل أن تكون مصدراً للقوة من خلال الاعتماد على قاعدة طائفية من جهة وتشجيع العداوات المتخيلة بين تلك الجماعات من جهة أخرى، مع العلم أن تلك الجماعات السكانية، وبغض النظر عن النسب، ليست كتلة صماء، وإنما تتباين في المواقف والمصالح وتخضع لتناقضات داخلية وصراعات مثلها مثل أي جماعة أخرى، يتشابك فيها الديني مع السياسي مع الاقتصادي (المصالح).
خلقت هذه الهيمنة مظالم كبرى، زادت من تأجيج الصراع، خاصة بعد الثورة وما شهدته من فظائع ارتكبها النظام بحق السوريين، إلى درجة أن الطائفية أصبحت خط الصدع الوحيد الذي يتمتع بسلطة فعّالة على الجميع. ورثت الإدارة الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام بلداً مدمراً يعاني من الفقر والتهميش والانقسامات الطائفية. وهي انقسامات عميقة يتأثر بها الجميع، يبدو الخلاص منها حتى على مستوى الخطاب أمرًا يحتاج إلى سنوات طويلة. وهذا يتطلب من الجميع وخاصة من السلطة بناء خطاب وممارسة دقيقتين، يركزان على خلق التقارب والوحدة بين مختلف الجماعات الإثنية والدينية، فمستقبل سوريا يكمن في القدرة على بناء هذا الخطاب والسلوك، كما أن الفشل في ذلك قد يدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة.
مثلت أحداث آذار في الساحل، وما تلاها من تطورات في السويداء وبعض مناطق ريف دمشق (جرمانا وأشرفية صحنايا)، الاشتباك الأول للخطاب السياسي مع حالة الانقسامات تلك، حيث أخذ شكلاً انفجارياً يعكس عمق الأزمة الطائفية. فالخطاب الذي تقدمه تلك الجماعات حول شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي كان خطاباً أيديولوجياً يسعى لتعبئة طائفية، ومحاولة للحفاظ على امتيازات قديمة أو خلق أخرى جديدة، مع نزعات تفتيتية، فلم يكن حديثهم عن دولة المواطنة سوى قناع زائف لمطالب أخرى. ونتيجة ربط النظام للطائفة بوجوده، بغض النظر عمّا إذا كان جميع أفرادها موافقين أو مستفيدين، وفي ظل غياب صوت جماعي يرفض الفظائع التي ارتُكبت خلال الثورة (رغم وجود أصوات فردية معارضة)، وجد العلويون أنفسهم محاصرين بين مطرقة الانتقام وسندان النظام، وضحايا لتلك السياسة.
يتفق معظم السوريين، في الخطاب، على قيام دولة قانون تحقق الكرامة والحرية، لكن تظهر التناقضات والصراعات حول مضمون هذه الدولة وطريقة تحقيقها، ما يكشف عن عمق الجذور الطائفية التي تغلف الممارسة السياسية والمصالح الضيقة وتفقدها مصداقيتها. ومن جانب آخر، يظهر ضعف بنية الجماعات السياسية. كان غياب صوت العقل والنقد الموضوعي هو السائد، باستثناء بعض الأصوات الفردية، حيث غابت السياسة بمعناها الحقيقي كصراع وتسويات بين قوى اجتماعية، وتحولت إلى اشتراطات وطلبات واجبة التنفيذ.
أمام هذه التركيبة والصدوع العميقة، يبقى المخرج الوحيد هو العمل على بناء دولة من خلال تأسيس جيش وقوات أمن على أسس وطنية مهنية، تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري. دولة تعمل على بناء هوية وطنية سورية تقوم على المواطنة التي تساوي بين الجميع، وتخلص البلاد من منطق الأكثرية والأقلية القائم، دون تمييز لجماعة على أخرى تحت ذريعة حماية الأقليات كما يطالب البعض في الداخل والخارج، وتقوم على نظام يعتمد التنوع السياسي أولاً، الذي يضمن سلامة التنوع الثقافي والاجتماعي لا العكس، ويكفل مشاركة عادلة للجميع، وأولى تلك الخطواب بناء جيش وقوات أمن على أسس وطنية، وهو انجاز هائل إن تمكنت الحكومة الجديدة من تحقيقه، إضافة للتخلص من المناهج التعليمية المتعددة ذات الصبغة الأيديولوجية، والاهتمام بمسألة العدالة الانتقالية من خلال محاسبة رمزية أو فعلية على الجرائم والانتهاكات.
ويبقى في النهاية القول إن فهم الأزمة السورية من منظور طائفي فقط هو فهم تبسيطي، يتجاهل تعقيدات أخرى مثل: الصراعات الاجتماعية البينية، والقوى الخارجية ونزعات الهيمنة لديها، والنظم السلطوية. فالطائفية ليست سوى واحدة من أدوات التدمير لدى القوى المهيمنة، كما أن الخلاص منها هو عملية سياسية بامتياز، طويلة الأمد، تبقي على التنوع في إطار الوحدة، فمصدر قوة البلدان اليوم تنوعها، ومستوى الحرية فيها.
تلفزيون سوريا
——————————–
السوريون وقميصُ عثمان المُدمّى
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
انطلاقاً من ضرورةِ ضبط إيقاع المخاض النهضوي العسير في المرحلة الانتقالية، شهدت سورية تغييرات سريعة منذ فرار بشّار الأسد، أهمها قرار رفع العقوبات الغربية الذي أعلنه دونالد ترامب في كلمةٍ له في الرياض، ليُعتبر الهدية الثمينة الثانية بعد إسقاط نظام الأسد، ويشكّل منعطفاً حاسماً في مسار الدولة والمجتمع يُعيد رسم علاقة سورية بالعالم من حولها، خصوصاً وأنّ الرئيس الأميركي أخبر أحمد الشرع أنّ لديه فرصة نادرة لقيامةٍ عظيمة في بلاده بعد منح شعبه بداية جديدة. وأقول: السوريون، بدورهم، يملكون فرصة تاريخية لن تتكرر لرفع ما هو ألعن وأكثر خطورة، وأقصد بالطبع القيود الطائفية.
في المقابل، شكّل القرار تطوراً دراماتيكياً هاماً فتحَ الباب أمام تساؤلاتٍ ملتهبة بشأن جدوى هذا التحوّل المفاجئ بالتوازي مع إرث النظام المخلوع وتداعياته على بلد خرج لتوّه من الجحيم، وعلى جنباته المُقفرة تنفجر الأحقاد المعلّقة، تحت مشاهد مذابح طائفية، أو صدامات ومظاهرات طائفية، بما يوحي وكأنّ سورية دخلت حقبة أبدية، لكن بسياقٍ آخر.
من هنا، من الدقّة بمكان الإشارة إلى أنّ ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة. ويبقى السؤال الملحّ أنه ووسط الفراغ الأمني الهائل القائم على الاستقطاب المذهبي والعرقي، كيف سيكون السوريون جديرين بكرم ترامب غير المسبوق؟ يرتكز الجواب على حفنةِ تفاؤل، خصوصاً وأنّ المُعطيات المتوفّرة، حالياً على الأقل، تؤكد أنّ الطائفية لن تكون المشكـلة التي ستعاني منها سورية المستقبلية اللامركزية، وهي تسير قدماً باتجاه “الفدرلة”، إنْ جرى تقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات حسبما أعلن عنه وزير الداخلية السوري في الآونة الأخيرة.
ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة
بالتساوق مع ما تقدّمـ يقع على عاتق السلطة الحالية مسؤولية خلق وعي سياسي ووطني ضمن فضاءات مدنية واسعة، لردع الخطابات الديماغوجية الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك المهرجانات الدعوية الكاريكاتورية والتجاوزات المستفزّة، التي لم تكن مجرّد تصرّفاتٍ خرقاء فردية من متديّنين متشددين ومتحمّسين، إذ كشف زخمها مستويات عالية لخطاب الكراهية والإقصاء، أيضاً تسويق مصطلحَي الأغلبية “المُباركة” والأقلية “المُدانة”، ما يمثّل عصياناً يمهد لحالة انقلابية على الهوية الوطنية الجامعة، وإشاعة حالة عدم يقين في وقتٍ تحتاج البلاد فيه إلى رأب التصدعات وهدم الجدران العازلة التي خلّفها النظام البائد، الذي روّج كذبة كبيرة أنه “حامي” الأقليات. لنتذكّر: عند تأسيس الجيش السوري عام 1945، نُقلت إليه كلّ مقدرات جيش الشرق البشرية، ومنها العلويون، الذين وجدوا أنفسهم بين الآباء المؤسسين للمؤسسة العسكرية، ولم يكونوا منبوذين ومضطهدين، كما ادّعى حافظ الأسد. وعلى السوريين اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، دحض تلك الأكاذيب، واستنكار المصطلحات المتداولة عن سُنّة أكثرية في دولة أموية يُعاد إنعاشها قسراً، بصفتها انحرافاً كارثياً عن طريق بناء بلد عابر للطوائف والأعراق.
فعلياً، لا توجد حساسية طائفية إلاّ عند من يتبنّاها ويسوّقها، بالتالي فإنّ التضخيم المغرض للسرديات الطائفية وارتفاع الأصوات المحرّضة، هدفه تسهيل الطريق لتمزيق النسيج الاجتماعي، بداية في الساحل السوري، ولاحقاً في البيئة الدرزية بعد التسجيل الصوتي المفبرك وتداعياته الكارثية، وعلى الطرف الآخر ترتفع نسبة شيطنة “الأكثرية” من قبل “أيتام الأسد”، وشيطنة “الأقليات” من قبل المتطرفين الحاقدين، إضافة إلى باقي الطوائف والإثنيات، خصوصاً الكردية التي لا تخفي مخاوفها الوجودية من المستقبل…إلخ، هذه الدوامة الطاحنة لم تُوقع السوريين في الفـخّ الطائفي المُحكم، بدلالة أنه وفي الوقت الذي تظهر به أصوات تتناول مجريات الأحداث المشتعلة بأبعاد طائفية وبلغة عنصرية مقيتة لا تخدم إقامة السلم الأهلي، تظهر أصوات مقابلة تُدين هذا “الزعيق الطائفي” وتسخّفه في مكان. وخير دليل على ذلك ملصقاتٌ عُلّقت في اللاذقية تدعو إلى تكفير العلويين، ليزيلها عقلاء من السنّة على الفور.
وعليه، التذكير بأسباب الطائفية ليس مجرّد اجترار مجاني للماضي وإنما إنعاش للوعي المغيّب بما يجب أنّ يُعلَمَ بالضرورة، ومن ثمّ، فإنّ استحضار أحداث حماة (1982)، مثلاً، والتي فعّلت نبرة الطائفية إلى الحدود القصوى بعدما كانت في مستواها الأول غير الملموس، مدخلٌ لازم للبحث في سُبل الشفاء من اللعنة السوداء التي فُرضت على السوريين وأصبحت ملازمة لهم، بعدما دفعهم نظام الأسد للتمسك بهوية إيمانية دوغمائية تضع الذات في مفارقة جدلية عقيمة مع الآخر المختلف لفرض حالة تضاد صدامي صالحة دائماً للاستثمار، ما يجعل اللوحة الفسيفسائية السورية المصطلح الأكثر ابتذالاً الذي عرفه السوريون يوماً.
نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم
بطبيعة الحال، يُجمع مراقبون على أنّ الطائفية بمزاجها المتشدّد دخيلةٌ على المجتمع السوري المتسامح نسبياً، ولا شك مرّت نزعة “الشِقَاق الوطني” بمحطات هبوط وصعود بلغت مداها في عهد نظام الأسد، الذي رعاها ضمناً وأنكرها علناً، معيداً ترتيب مفردات الاختلاف الطبيعي بين المكونات السورية لتخديم سلطته العميقة وتكوين آلته القمعية. وحين رُفع غطاء الجحيم عن البلاد أخيراً بإعلان نهاية حكم الأبد إلى غير رجعة ظهرت أمراضٌ مجتمعية ساهم في صناعتها، وهي، في جوهرها، ليست إلاّ سجال الألم وسعار الغضب اللذين ينتهيان دائماً إلى عباراتٍ سامّة، من قبيل “نحن” و”هم”. واليوم، وفي لحظة مفصلية حرجة تشهدها سورية والمنطقة، المتاح إما مصالحة وطنية تُنهي تراشق التهم الطائفية بين الأطراف المختلفة أو أن تغدو التحالفات والأيديولوجيات سبيلاً لتثبيت مشروع “أفغنة” الدولة، وهي أفضل السيناريوهات الممكنة حينها، أو لمشروع احترابٍ دموي دائم في أسوئها.
يتوجب الجزم بيقين أنّ المشكلة الطائفية لم تنشأ بسبب التنوّع وتناقض مصالح الطوائف، بل تكمن أساساً في الاستثمار السياسي فيها، ولا يمكن اجتثاثها من جذورها إلا بترسيخ أسس الديمقراطية الفعلية، بعيداً عن منطق المحاصصة. والواقع أنّ ضرب الخطاب الطائفي لن يتمّ إلا مع سقوط الحاضن الأول له، وأقصد تركة الأسد، على القدر نفسه من الأهمية، بوقوف السوريين جميعهم بحزمٍ ضد التخوين والعنصرية، خاصة تحريض سوريّي الخارج وقراءتهم مسبَقة الصنع للمشهد السوري، والذين انتقلوا بسرعةٍ مريبة من الانتقاد إلى مدافعين شرسين عن الحكومة الجديدة، لإيمانهم أنَّ “القوة دائماً على حقّ”. ولا نبالغ إذ نقول إنه ينطبق على الطائفية السورية توصيف “قميص عثمان المُدمّى”، الذي رفعه بنو أمية والنيّة المُضمرة لم تكن الثأر لعثمان، بل الوصول إلى نيل السلطان، واليوم تشهد الفضاءات السورية العامة ارتفاعاً مهولاً وممنهجاً في الخط البياني لخطاب العدالة “الانتقامية” بقصد الهيمنة والتمكين، ما يؤكد على رُدّة وطنية للوافدين من أماكن التطرّف، وربما القهر، وبذريعة الشعار الأكثر استبداداً “من يحرّر يقرّر”.
نافل القول: تراجع الأزمة السياسية سينجم عنه بالضرورة تراجع في التوتر الطائفي، أما التعامل معه، بوصفه تحصيل حاصل لما تقدّم ذكره، فضرورة ملحّة لا تستوجب الإنكار أو التأجيل، باعتباره آفة مارقة تجعل التسليم بزواله نتيجةً لا جدال حولها. بالتالي، نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم، لمواجهة خطر هذا الطاعون القاتل، ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، لأنه، ببساطة شديدة، مصدرُ تفرّق وعداوة ضدّ التنوع والاختلاف، وأيضاً ضدّ الحياة.
العربي الجديد
———————–
=========================