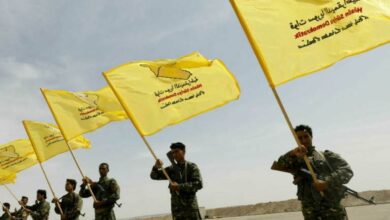سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 25 أيار 2025
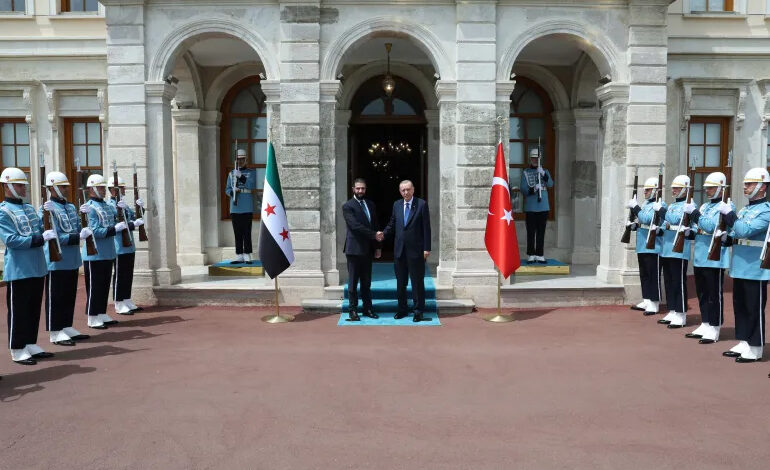
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————-
ما دلالات زيارة الشرع المفاجئة إلى تركيا؟/ زيد اسليم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. 25/5/2025
أنقرة- في زيارة غير معلنة هي الثالثة له إلى تركيا منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى إسطنبول، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولما بهتشة.
وعُقد اللقاء خلف أبواب مغلقة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين من الجانبين، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، كما ضم من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصر.
سياق الزيارة
تأتي زيارة الرئيس السوري إلى تركيا في سياق إقليمي ودولي بالغ الأهمية، إذ تزامنت مع إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الغربية بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد يومين فقط من زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق، والتي تناولت ملفات أمنية حساسة، خاصة قضية تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية، وهو الملف الذي شهد تأخرا في التنفيذ عما كان معلنا سابقا.
وتأتي أيضا في ظل تصريحات أردوغان الأخيرة حول التواصل مع العراق وسوريا بشأن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مما يعكس مساعي تركيا لتحقيق تقدم في هذا الملف الأمني الحساس.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أهم الملفات
أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن اللقاء تناول جملة من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا ومسارات التعاون بين البلدين.
وأكد الرئيس أردوغان، خلال المباحثات، أن “أياما أكثر إشراقا وسلاما” تنتظر سوريا، مجددا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري كما فعلت منذ بداية الأزمة.
ورحب أردوغان بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر ذلك خطوة مهمة تهيئ الأرضية لعودة الاستقرار.
وفي ما يخص التصعيد الإسرائيلي، وصف الرئيس التركي الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدا استمرار تركيا في رفضها هذه الانتهاكات عبر كل المنابر الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في مجالات حيوية، على رأسها الطاقة والدفاع والنقل، إذ أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوفاء بما تقتضيه علاقات “الجوار والأخوة”، بما يشمل الدعم الفني والسياسي خلال مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.
وفي المقابل، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن امتنانه للموقف التركي، مثنيا على الدور الحاسم الذي لعبته أنقرة في رفع العقوبات ودفع المجتمع الدولي للاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق.
من جهتها، قالت الوكالة السورية للأنباء إن وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيان نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري ووزير خارجيته التقيا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، لبحث تطورات الملف السوري خلال الزيارة.
في السياق، يرى الباحث في مركز سيتا للدراسات كوتلوهان قورجو أن غياب أي إعلان رسمي أو تغطية إعلامية مسبقة لزيارة الرئيس السوري إلى تركيا لا يعني بالضرورة أنها كانت سرية، بل يعكس -برأيه- ضيق الحيز الزمني للزيارة، وطبيعة الملفات الحساسة المطروحة خلالها.
ويعتقد قورجو -في حديث للجزيرة نت- أن من بين العوامل التي دفعت لعقد هذا اللقاء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتعيين السفير الأميركي لدى أنقرة مبعوثا خاصًا إلى سوريا، إلى جانب تصاعد أهمية ملف وحدات حماية الشعب (قسد) في الأجندة الأمنية التركية.
ويلفت إلى أن مشاركة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في اللقاء تعزز الاعتقاد بأن قضية انتشار القوات الكردية وقضية “المواقع العسكرية المحتملة” كانتا ضمن أولويات جدول الأعمال، إلى جانب ما وصفه بـ”التقدم الفني في الحوار التركي الإسرائيلي بشأن سوريا”، الذي قد يكون طُرح أيضًا في اللقاء.
وأضاف قورجو أن لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص توم باراك يعكس حرص القيادة السورية الجديدة على التواصل المباشر مع واشنطن، وإدراكها حساسية هذا المسار، في ظل استمرار وجود ملفات عالقة بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الزيارات الميدانية التي أجراها مسؤولون سوريون إلى تلك المخيمات قد تكون جاءت استجابة ضمنية لبعض التوقعات الأميركية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أهمية الزيارة
يرى المحلل السياسي محمود علوش أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت على المشهد السوري مؤخرا، لا سيما في ما يتعلق بمسار التسويات السياسية والأمنية.
وحسب علوش، فإن أنقرة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمعالجة ملف قسد ضمن إطار اتفاقية الاندماج الجارية، التي تشكل جزءا من مسار أوسع متعلق بإحياء عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. ويعتقد أن الظروف أصبحت ناضجة لتحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الانسجام الأميركي النسبي” مع مقاربة تركيا للملف السوري.
كما يشير إلى أن أنقرة معنية أيضا بالتوصل إلى ترتيبات أمنية ثنائية مع دمشق ودول الإقليم لمواجهة تهديد عودة تنظيم الدولة (داعش)، بما يشمل ملف تسليم سجون داعش ومعسكرات الاحتجاز إلى الحكومة السورية، وهي خطوة ترى فيها تركيا ضرورة لتمكين دمشق من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة على حدودها.
ويختم علوش بالقول إن النتائج المباشرة لهذه الزيارة ربما لا تظهر فورا، لكنها -برأيه- ستتجلى تدريجيا من خلال استكمال مسار الاندماج وتنفيذ التفاهمات الأمنية والعسكرية التي جرى التوافق عليها بين الجانبين.
المصدر : الجزيرة
———————————–
في زيارة غير معلنة.. الشرع يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث ملفات أمنية وسياسية
24 مايو، 2025
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مباحثات مهمة في إسطنبول مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة غير معلن عنها مسبقاً، تناولت تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي.
اللقاء الذي انعقد في المكتب الرئاسي داخل قصر دولمة بهشة التاريخي، شهد حضور شخصيات بارزة من الطرفين، حيث شارك من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، بالإضافة إلى رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
أما الوفد السوري فضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
ووفقاً لمصادر تركية، جدد الرئيس إردوغان خلال الاجتماع تأكيده على استمرار دعم تركيا للإدارة السورية الانتقالية بهدف تحقيق الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وشدد على أهمية التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في ما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية.
كما ناقش الجانبان مسار تنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مارس الماضي، والذي لم يشهد حتى الآن تقدماً ملموساً، الأمر الذي يثير قلق أنقرة. وتطالب تركيا بنقل السيطرة على السجون والمعسكرات التي تضم عناصر تنظيم “داعش” إلى الحكومة السورية كجزء من هذا الاتفاق.
الهجمات الإسرائيلية والعقوبات الغربية على طاولة النقاش
كما تطرقت المباحثات إلى التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما من تأثير الهجمات المتكررة على استقرار المنطقة.
كما ناقشا إمكانية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، والخطوات العملية المطلوبة لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالين، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني، بالإضافة إلى رئيس المخابرات السورية حسين السلامة.
وتناولت هذه اللقاءات التنسيق الأمني، خاصة فيما يتعلق بإعادة دمج عناصر “قسد” في صفوف الجيش السوري، وضبط الحدود والمعابر، وتسليم السجون التي تحتجز فيها عناصر تنظيم “داعش” إلى الدولة السورية.
دعوة تركية لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة
وفي هذا السياق، دعا أردوغان الحكومة السورية، يوم الخميس، إلى المضي في تنفيذ اتفاق دمج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية، في خطوة تعتبرها أنقرة ضرورية لتجفيف منابع التوتر في الشمال السوري.
ولفت إلى أن لجنة رباعية تضم كلاً من تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة تتابع ملف معتقلي “داعش” الموجودين في معسكرات شمال شرقي سوريا، والتي تسيطر عليها قوات “قسد”.
وأشار أدوغان إلى ضرورة تحمّل العراق لمسؤولياته حيال مخيم “الهول”، حيث أن معظم النساء والأطفال المحتجزين هناك من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
انطلاقة نحو تعاون دفاعي متكامل
اللقاء الرفيع شهد أيضاً مؤشرات قوية على انطلاق مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق، وسط تقارير عن اتفاق وشيك لإقامة قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.
وقد جاء حضور وزيري الدفاع من الجانبين، بالإضافة إلى رئيس الصناعات الدفاعية التركية، كإشارة واضحة إلى عمق التنسيق الدفاعي بين الطرفين.
وفي تطور لافت، كشفت وزارة الدفاع التركية عن زيارة قام بها وفد برئاسة المدير العام للدفاع والأمن، اللواء إلكاي ألتينداغ، إلى دمشق، حيث التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحثا آفاق التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.
اتفاق استراتيجي في مجال الطاقة
اقتصادياً، وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير الخميس اتفاقية تعاون مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، تشمل مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات.
وتعهدت أنقرة بموجب الاتفاقية بتزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بالإضافة إلى دعم شبكة الكهرباء السورية بما يعادل 1300 ميغاواط من الإنتاج الإضافي.
كما أعلنت تركيا استعدادها لتزويد دمشق بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية الاحتياجات العاجلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
——————————
سوريا بوصفها بلد اللايقين/ عمر قدور
السبت 2025/05/24
قبل ثلاثة أيام أعلنت وزارة السياحة عن استدراج عروض للاستثمار السياحي لعدد من المواقع، من بينها بيت “أبو خليل القبّاني” الذي هناك مطالبات أصلاً بتحويله إلى متحف، أو إلى متحف ومحترف مسرحي يليقان بتكريم الرائد الراحل. في اليوم نفسه أُعلِن عن اجتماع بحث فيه وزير الثقافة مع المركز السوري للإحصاء والبحوث مشروعَ إنشاء منصة إلكترونية لتوثيق العدالة الانتقالية في سوريا، بينما كان وزير التنمية الإدارية (حسب المعلن على صفحة الوزارة) يعقد مع وزير الأوقاف اجتماعاً “خُصص لمناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف، كمدخل أساسي لتحقيق التحول المؤسسي الشامل للجهات العامة”!
وحده الخبر الخاص باستثمار بيت أبي خليل القباني أثار استياء محدوداً لدى بعض المثقفين، أما تدخل وزير الثقافة غير المفهوم في موضوع العدالة الانتقالية فلم يثر الانتباه، وكذلك حال اعتبار الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف مدخلاً أساسياً لتحقيق التحول المؤسسي الشامل للجهات العامة. لكن، رغم الحيوية الظاهرة في سجالات السوريين، نجزم بأن النقاش في أي تفصيل (مما سبق أو غيره) لن يكون من شأنه التقدم خطوة إضافية في مجمل قضايا الشأن العام. جزء من هذه المراوحة في المكان يعود إلى الاصطفاف شبه النهائي بين موالي السلطة من جهة، والذين ليسوا من موالاتها مع اختلاف درجاتهم وأسبابهم.
أخبار كالتي أتت في المستهل يمكن أخذها دلالة على التخبط الحكومي، مما لا يوحي بالثقة بالأداء عموماً. ويمكن، في المقابل، الإتيان بأخبار وزارية “إيجابية” بالمعنى الذي يشير إليه الموالون، وهكذا يبدو الأمر كأنه تنازع بين رؤيتين منحازتين ليس إلا، وبين الذين يمنحون السلطة ثقتهم والذين لا يفعلون ذلك. أيضاً، من وجهة نظر كل طرف ثمة يقين من الثقة أو عدمها، بلا انتباه كافٍ إلى أن تناقضات الوضع السوري الحالي قد لا تكون عفوية، وقد يكون هذا السجال مظهراً مما هو متعمّد أصلاً في تناقضاته.
اليوم مثلاً يستطيع شخص تأكيد منع المشروب الكحولي في مطعم ما في دمشق القديمة، ليأتي شخص آخر ويؤكّد أنه بنفسه تناول الكحول في مطعم آخر في المنطقة ذاتها. تستطيع امرأة سافرة القول إنها لم تتعرض لأية مضايقة تخص ملبسها في بقعة ما من سوريا، بينما يؤكد شبّان أنهم مُنعوا من لبس الشورت في مكان آخر، فيُستنتج أن التعامل مع النساء أشدّ. اشتُهر حديث لمحافظ اللاذقية شكا فيه من قلة حشمة النساء على الشواطئ، وثمة تعميم من مديرية أوقاف دمشق يخص الحشمة في الملبس أثناء الصيف ومراعاة ما سُمّي “حرمة الطريق”، لكن أيضاً يستطيع أي شخص القول إنه لم يلاحظ في دمشق تطبيقاً إلزامياً للتعميم، ما يترك الأمر في حيز الالتزام الطوعي.
سؤال الحواجز عن ديانة ومذهب العابرين ليس قاعدة مطلقة، لكنه مؤكد من قبل كثر تعرّضوا لمهانته، وقد يُعفى منه ركاب سيارة خاصة بفضل وجود نساء محجبات كدلالة رمزية على منبت مذهبي. وإذا شئنا تتبع هذه التفاصيل نحتاج إلى وقت طويل جداً، بما فيها التفاصيل التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، ومع إعلان الحكومة الذي ذُكر في أحد بنوده الالتزام بحقوق الإنسان وبالاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا من قبل على هذا الصعيد. حالة اللايقين تصل إلى حد وجود اختلاف بين بيان رئاسة الجمهورية في سوريا وبيان رئيس الاتحاد الأوروبي، إثر اتصال الثاني لتهنئة الرئيس الشرع برفع العقوبات الأوروبية عن سوريا. ففي حين أشار بيان أنطونيو كوستا إلى حديث الشرع عن الديموقراطية، لم يذكر بيان الرئاسة هذه الكلمة على الإطلاق.
من جهتها، لا تفعل السلطة ما يوحي بأنها تريد تبديد حالة اللايقين، الأمر الذي يحيل إلى كون اللايقين نهجاً أكثر من كونه تعبيراً عن الفوضى والاعتباطية. ففي دلالة مهمة لم يُسجّل لها محاسبة أحد من مرتكبي التجاوزات أو الانتهاكات، مع وجود حالات لمرتكبي التجاوزات الذين أوقفوا لساعات قليلة، ثم خرجوا على وسائل التواصل متباهين بالإفراج عنهم. ومن التبريرات الشائعة أن قيادة السلطة لا تريد إغضاب قاعدتها الأيديولوجية، لذا تسمح بارتكاب التجاوزات ضمن حدود “محسوبة”، على سبيل إرضاء مؤيديها المتطرفين والتنفيث عن غضبهم.
ينطلق التفسير الأخير من التفاؤل بأن التجاوزات مُسيطَر عليها، وبأنها مؤقتة حتى يحين موعد تمكين تيار الاعتدال فيرغم أولئك المتطرفين على القبول بالأمر الواقع. أصحاب التفاؤل أنفسهم لا يلحظون أن تفسيرهم (المبني على اللايقين) يرضيهم، مثلما ترضي التجاوزات والانتهاكات سواهم، أي أنهم جزء من مؤيدي السلطة التي توضَعُ موضع التكهنات والرغبات؛ تماماً كما هو حال غيرهم الذين لا يملكون إجابات واضحة وقاطعة إزاء الكثير من الأسئلة.
تكسب السلطة من حالة اللايقين بقدر ما تكون توجهاتها أكثر غموضاً، لأن هناك نسبة كبرى من الجمهور الذي يتوسّم بها “خيراً” بقدر ما تسمح بالتناقضات في المرحلة الانتقالية الحالية. بهذا المعنى، تربح السلطة مرتين، مرة باجتذاب أكبر عدد من المؤيدين، وحتى الذين ليسوا خصوماً بعد. ومرة أخرى لأن عدم الحسم، وترك الاحتمالات معلَّقة، يمنعان الانتظام السياسي بمعناه الواسع. فاليوم لا يخفى أن الأنظار مصوَّبة إلى السلطة، والاصطفاف السياسي المقبل سيكون بدلالة ما تستقر عليه من توجهات أيديولوجية وحكومية.
اللايقين ليس حيادياً، فإذا أخذنا مثلاً حادثة مضايقة لامرأة غير محجبة، وفي المقابل عدم مضايقة أمثالها، فالسلوك الأول هو الأبلغ تأثيراً، لأنه سيدفع العديد من النساء إلى تحاشي احتمال المضايقة وتعديل نمط ملبسهن. كذلك هو الحال فيما يخص العديد من أنماط السلوك الاجتماعي، حيث يتجنّب كثر أنماطهم المعتادة كي لا يكونوا ضحايا “تجاوزات فردية”. استمرار الأخيرة هو بمثابة أداة تطويع اجتماعية تعمل في اتجاه وحيد يلتقي مع أيديولوجيا السلطة الحالية، سواء بنسختها السابقة أو الراهنة، أي أن ما يبدو تجاوزات الآن هو استثمار لتطويع مزيد من الجمهور الذي سيصبح أقرب لمزاج السلطة.
ومن حالات اللايقين التي سبق للسوريين اختبارها عندما تكون هناك حالة شك إزاء القانون، ولعل هذه هي الحالة الأساس في الحديث عن تجاوزات، فالقانون موجود نصاً، لكن يحدث التطاول عليه من قوة أعلى من القانون. مع مرور الوقت، تتعزز القناعة بأن السلطة (والأقوياء عموماً) فوق القانون، ما يؤدي إلى الإقلاع عن استخدامه كمعيار، وكآلية دفاعية تحمي الضعفاء. إن حالة اللايقين هنا تحطّم النظام العام بأكمله مع الوقت، ليكون مزاج السلطة غير الصريح أو المدوَّن هو القانون.
فيما يخص التعليق الضمني لدولة القانون، يمكن القول إن سوريا بلد اللايقين منذ عقود، ومغادرة العهد السابق تقتضي العبور السريع إلى الالتزام الذي لا لبس فيه بالقانون، أولاً من قبل السلطة المكلّفة بتطبيقه. إلحاح هذا الالتزام يزداد مع حالة اللايقين السياسية في مرحلة انتقالية تمتد طويلاً، لأن بقاء بلد في حالة شك شاملة سيكون من أكبر مصادر للفوضى التي يتم التحذير منها. وتحسّن حال الحريات السياسية (حتى الآن) غير كاف بغياب المنافسة السياسية وقوانينها الناظمة، لذا يبقى المحك راهناً في الحريات العامة، وفي أن تتجرّع السلطة الإقرار بها بلا لبس أو غموض؛ في النصوص وفي التطبيق الشامل والصارم، أي أن تتجرّع المطلوب منها داخلياً وخارجياً.
المدن
———————————-
معهد واشنطن: لهذا يشكل تنظيم “الدولة” تهديدا للحكومة السورية الجديدة
تحديث 24 أيار 2025
نشر د. هارون ي. زيلين وهو زميل سابق في برنامج الزمالة “غلوريا وكين ليفي” في “برنامج جانيت وايلي راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات” في معهد واشنطن، تحليلا على موقع المعهد، قال فيه إن “تنظيم الدولة” نجح لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، في استهداف السلطات السورية الجديدة، عبر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً أمنياً في بلدة ميدان الشرقية في 18 أيار/مايو، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وسواء كان الهجوم مقصوداً أم لا، فقد تزامن مع تطورات مهمة أخرى في الملف السوري. وقد وقع الهجوم بعد يوم واحد من اشتباك القوات الحكومية مع خلية تابعة لتنظيم “الدولة” في حلب في أول كمين من نوعه منذ آذار/مارس، وأقل من أسبوع على لقاء الرئيس ترامب بالرئيس أحمد الشرع في الرياض، إضافة إلى أنه جاء عقب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في منتصف نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أن وجود تنظيم “داعش” لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقاً، إلا أن المؤشرات تُظهر استمرار التهديد بدرجة لا يمكن تجاهلها.
وبحسب الكاتب واصل تنظيم “الدولة” نشاطه كحركة تمرد محدودة النطاق في ظل الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة في كانون الأول/ديسمبر. وفى الخامس عشر من أيار/مايو، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تنفيذ 33 هجوماً خلال عام 2025. فمن ناحية، إذا استمرت هذه الوتيرة المنخفضة تاريخياً، فسينتج عنها 89 هجوماً فقط خلال العام بأكمله – وهو رقم كبير بطبيعة الحال، لكنه يُعد الأدنى منذ دخول التنظيم إلى سوريا عام 2013.
ومن ناحية أخرى، سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات منذ نيسان/أبريل، حين بدأت الولايات المتحدة بتقليص وجود قواتها من 2000 إلى نحو 700 جندي. ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان ذلك محض مصادفة، كما أن حجم القوات الحالي لا يقل عن ذلك الذي حافظت عليه واشنطن قبل تعزيز انتشارها في أنحاء الشرق الأوسط خلال حرب غزة. ومع ذلك، ارتفع متوسط عدد الهجمات التي أعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عنها من نحو خمسة هجمات شهرياً في النصف الأول من العام إلى 14 هجوماً شهرياً منذ بدء الانسحاب.
ووفق الباحث يحمل موقع هذه الحوادث دلالة مهمة أيضاً، فحتى الأمس، وقعت جميعها في مناطق تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ذات القيادة الكردية، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي تخوض عملية واعدة لكنها لم تكتمل بعد لدمج قواتها في الجيش السوري، حتى مع انسحاب الولايات المتحدة. وليس مستغرباً أن يسعى تنظيم “داعش” إلى استغلال هذا الوضع، انسجاماً مع نهجه التقليدي في ملء أو زعزعة الاستقرار في أي فراغ، مهما كان محدوداً. ويمثل استهداف مدينة الميادين – الواقعة في أراضٍ تخضع لسيطرة الحكومة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، خارج نطاق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” – تصعيداً لافتاً على المستويين الرمزي والميداني.
وبحسب مؤلف كتاب “عصر الجهاد السياسي: دراسة عن هيئة تحرير الشام” ففي غضون ذلك، تواصل السلطات الجديدة في دمشق المعركة التي تخوضها ضد تنظيم “الدولة” منذ سنوات – على ساحة القتال باعتبارها جماعة جهادية منشقة تحت اسم “جبهة النصرة” ثم “هيئة تحرير الشام” منذ عام 2013، ومن خلال نهج المواجهة القانونية بعد إنشاء كيان حكم مستقل في محافظة إدلب عام 2017، وعلى جميع الجبهات منذ الإطاحة بنظام الأسد العام الماضي. فعلى سبيل المثال، في 11 كانون الثاني/يناير، أحبطت السلطات السورية مخططاً لتنظيم “داعش” يهدف إلى إثارة التوترات الطائفية عبر تفجير ضريح السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق. وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن هذا المخطط، في اختبار مبكر للتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب. ووفقاً لوزارة الداخلية، اعترف المشتبه بهم أيضاً بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة ضد كنيسة في بلدة معلولا في يوم رأس السنة الجديدة، واغتيال الرئيس الشرع إذا زار السيدة زينب بعد الهجوم الفاشل.
وذكر أنه في 15 شباط/ فبراير، اعتقلت السلطات السورية أبو الحارث العراقي، أحد قادة “داعش” في ما يسمى بـ”ولاية العراق”، الذي ساهم في تنظيم مؤامرة السيدة زينب الفاشلة. وكان قد شارك سابقاً في اغتيال زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو مريم القحطاني في نيسان/أبريل 2024. كما اعتقلت مديرية الأمن العام خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في محافظة درعا هذا العام في بلدة النعيمة في 18 شباط/فبراير وبلدة الصنمين في 6 آذار/مارس.
حتى الأيام القليلة الماضية، بدا الوضع العام داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة هادئاً نسبياً. لكن خلال عملية مداهمة في حلب بتاريخ 17 أيار/مايو، فجر أحد عناصر تنظيم “داعش” نفسه، واعُتقل أربعة آخرون، وقُتل ثلاثة من أفراد الحكومة. ولقي المزيد من أفراد قوات الأمن حتفهم في تفجير بلدة الميادين في اليوم التالي. من جانبها، شنت “قوات سوريا الديمقراطية” حوالي ثلاثين عملية اعتقال هذا العام ضد خلايا تنظيم “داعش” في الشرق، وهو عدد أقل من الأعوام السابقة، لكنه لا يزال مرتفعاً.
ووفق الباحث تسلط كل هذه الاتجاهات الضوء على حقيقة أن عمليات تنظيم “الدولة”، رغم تراجعها الكبير، لا تزال قادرة على إحداث اضطرابات كبيرة، لا سيما خلال الفترة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لديها أسباب أكثر من أي وقت مضى لعدم سحب قواتها بالكامل من سوريا لحين استكمال السلطات الجديدة دمج “قوات سوريا الديمقراطية” وتأسيس حملة مكافحة تنظيم “داعش” على أسس أكثر استدامة. ويتطلب هذا حث الأكراد ودمشق على المضي قدماً في الاتفاق القائم الذي ينص على أن تتولى الحكومة المركزية السيطرة على كامل محافظة دير الزور، معقل تنظيم “داعش”. وبذلك، سيتم إنشاء إدارة واحدة في المحافظة، مما يمنع التنظيم من استغلال الفجوات بين منطقتي السيطرة، وهي نقطة ضعف لعبت على الأرجح دوراً في الهجوم الناجح.
وبرأي الكاتب فإن عدم اكتمال الاندماج الإداري في الشمال الشرقي يزيد من خطر أن يحاول تنظيم “الدولة” مرة أخرى تحرير 9000 مقاتل مسجون وآلاف آخرين من أفراد أسرهم وأنصارهم المحتجزين في مرافق احتجاز “قوات سوريا الديمقراطية”، وبعضهم من الرعايا الأجانب.
ويمكن لواشنطن المساعدة في الحد من هذا الخطر من خلال مواصلة الضغط على الدول لإعادة مواطنيها المحتجزين. ومما يعقد هذه المشكلة، أن نشرة “تنظيم الدولة” الإخبارية “النبأ” الصادرة الأسبوع الماضي لم تكتفِ بدعوة المقاتلين الأجانب إلى سوريا، بل حثت أيضاً مقاتلي “هيئة تحرير الشام” غير الراضين عن سياسات الحكومة الجديدة على الانشقاق، وهو نداء يتكرر كثيراً وقد يكون له تأثير إضافي حالياً مع تصاعد الضغط الأمريكي لطرد جميع هؤلاء الأفراد.
وخلص الباحث للقول إنه باختصار، على الرغم من الضعف الحالي لتنظيم “الدولة” من الناحية التاريخية، فإن استبعاد الخطر الذي يشكله التنظيم سيكون خطأً، كما أن اتخاذ أي قرارات سياسية أمريكية على المدى القريب بناءً على هذا الافتراض سيكون خطأً أيضاً.
القدس العربي
———————————-
الإنزال المظلّي على المؤسسات الثقافية السورية/ خليل صويلح
لم تكن الثقافة السورية امتدادًا للنظام السابق، باستثناء الجزر الرسمية فيها. وهناك عشرات الأفلام والعروض المسرحية والنصوص الأدبية التي خاضت معارك شرسة، انتهى كثير منها بانتصار مبدعيها على خصومهم في دوائر الرقابة.
أجل، هناك من يسعى إلى “تدمير” كل ما يخصّ تاريخ الثقافة السورية في ظل النظام الآفل بوصفها ثقافة خنوع واستبداد وطغيان، وذلك برسم خرائط مزوّرة تعمل على محو التضاريس الناتئة في الحقل الإبداعي السوري خلال نصف القرن المنصرم، بجرّة قلم.
وكأن هذه الحفريات ترجيع لمنهج “البعث” وحده، وليست نتاج ورشة إبداعية لطالما اشتغلت من خارج المنهاج المقرّر، فيما انكفأت الثقافة الرسمية نحو تدبيج شعارات جوفاء لم تترك أثرًا فعليًا في الفضاء العام.
وتاليًا، فإن وضع الثقافة السورية عمومًا في قفص الإدانة والاتهام، يقع في باب الخفّة والانزلاق إلى لحظة ضبابية تبدو أكثر خطرًا على الميراث السابق لجهة الانغلاق على مفردات ماضوية تطيح حرية التعبير في المقام الأول.
إن فحص المشهد العمومي للثقافة السورية، ما قبل سقوط النظام، ينطوي في العمق على تأصيل نصّ مارق، كان يتسلل من ثقوب المؤسسة الرسمية بطرق مختلفة، بعد أن أدركت الشيخوخة مكاتب هذه المؤسسات واهترأت شعارات حزب “البعث” التي لم تعد تقنع أصحابها أنفسهم.
هكذا، اكتفت السلطة بحجز الصفحات الأولى من الجرائد اليومية لأخبار القائد ومنجزات الحزب، فيما تفلتت الصفحات الثقافية من القبضة الصلبة للممنوعات بطرق مراوغة أصبحت جزءًا من مهارات المبدع السوري، ليس في الصحافة فحسب، إنما في الحقول الأخرى كلها.
ففي نظرة عجلى إلى أرشيف السينما السورية، سنقع على أفلام نوعية لم تتمكن الرقابة من خلع أنيابها. فما كان يُمنع من العروض الجماهيرية كان يجد ملاذه في العروض الخاصة والمهرجانات الدولية. والأمر ذاته في ما يخصّ العروض المسرحية والنصوص الأدبية، في معارك شرسة كانت تنتهي غالبًا بانتصار مبدعيها على خصومهم في دوائر الرقابة.
سنتذكّر أفلامًا مثل “الليل” لمحمد ملص، و”نجوم النهار” لأسامة محمد، و”طوفان في بلاد البعث” لعمر أميرلاي، بالإضافة إلى الصخب الذي أثارته نصوص سعد الله ونوس، وممدوح عدوان في المسرح (عُرضت مسرحية “ليل العبيد” لليلة واحدة قبل منعها)، إلى عشرات النصوص الروائية التي تنتمي إلى “أدب السجن” والسرديات الأخرى المضادة.
لنقل إذًا، إن الثقافة السورية في عمارتها الأصلية أتت من موقع الضد في معظم أطروحاتها، ولم تخضع لشعارات “البعث”، عدا الجزر الرسمية المعزولة عن الفضاء الطليعي، بمنشورات تنتهي إلى رطوبة المستودعات وغبار الأرشيف.
اليوم، تدور سجالات ومعارك دونكيشوتية حول منظمة “اتحاد الكتاب العرب” وضرورة تنظيف مكاتبه من مثقفي السلطة. لا ننفي أن هذا الاتحاد مجرد ثكنة رقابية على المطبوعات، ومكان “أكل عيش” لا أكثر، ولكنه عمليًا كان مجرد واجهة مصنوعة من القش.
وتاليًا، فإن احتلاله بالإنزال المظلي لمصلحة ورشة جديدة مجهولة النسب الإبداعي في معظم أعضائها، لن يحقق ما كان يحلم به المبدعون إلا في حال إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات، وهو ما لم يتحقق إلى الآن، وضرورة استقطاب عشرات الشعراء والروائيين الذين شُطبوا أو رُفضوا من قوائم الاتحاد، فيما تسلل مئات الضباط المتقاعدين إلى عضوية الاتحاد بصفة شعراء وباحثين!
موقعة الإنزال المظلي ذاتها طالت مؤسسات أخرى مثل نقابة الفنانين، واتحاد التشكيليين، واتحاد الصحفيين، وذلك بإقصاء شخصيات مهمة وتعيين أسماء بلا رصيد أو خبرة أو مقترح تنويري، بانتظار وعود انتخابية يبدو أنها مؤجلة طويلًا!
ليس بإمكاننا تجاهل منجزات وزارة الثقافة، سواء على صعيد إنشاء المعاهد العليا للمسرح والسينما والموسيقا ودار الأوبرا والمكتبة الوطنية، أو نشر آلاف العناوين المهمة والمجلات المتخصصة. هذه الفضاءات أصبحت في مرمى الخطر اليوم لجهة تغيير بوصلة عملها برؤى لا ثقافية، وذلك بِهَيمنة شخصيات غامضة في تسيير عجلاتها أو تعطيلها على الأرجح.
هناك، إذًا، مخاوف حقيقية لدى المثقفين السوريين من محاولات هدم البنية التحتية للثقافة السورية بذريعة تأسيس مشهدية مغايرة لا تشبه جغرافية هذه البلاد تاريخيًا، واختراع تاريخ وهمي للأمجاد. ولعل أول مفاعيل هذه المشهدية تمجيد اللحظة بتعزيز حضور الشعر العمودي على حساب حداثة متأصلة، أسّست لها أسماء بارزة منذ ستينيات القرن المنصرم. وإذ بنا كمن يستبدل العمارة التاريخية بعمود الخيمة وحداء القوافل، ويستغني عن عسل النحل بحشود الذباب الالكتروني والأسماء الطارئة.
أوان
———————————
تنافس إقليمي على سوريا بعد سقوط نظام الأسد.. صراع معقد على النفوذ والمصالح/ حسان الأسود
2025.05.24
مثل سقوط نظام الأسد في سوريا نقطة تحول محورية، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات الإقليمية والدولية. فبعد عقود من حكم الفرد الواحد، يواجه هذا البلد الغني بالتاريخ والجغرافيا مستقبلًا غامضًا، تحكمه مصالح قوى دولية وإقليمية متنافسة، وتطلعات قوى محلية تسعى لملء الفراغ السياسي والأمني.
لطالما كانت سوريا في بؤرة تقاطع المصالح الدولية ومنذ فجر التاريخ، هذا بالذات كان أحد الأسباب في جعلها متنوعة سكانيًا وحضاريًا، باعتبار أنّ كل مجموعة بشرية سكنتها تركت فيها شيئًا خاصًا ومميزًا.
واليوم، مع الصراع المستعر على تثبيت قيادة أميركا للعالم الذي تخوضه إدارة ترامب، يجد السوريون والسوريات أنفسهم وبلدهم أيضًا محطّ تنافس لا يخلو من خشونة هنا ومراوغة ناعمة هناك.
كانت إيران طرف العصى الثانية التي وازن من خلالها حافظ الأسد علاقته مع الدول العربية، وطالما استخدم هذه العلاقة لابتزاز الطرفين.
تغيرت المعادلة باستلام بشار الحكم إرثًا عن أبيه، فقد أدت سياساته الهوجاء لزيادة النفوذ الإيراني بشكل كبير، مما أفقد سوريا ثقلها الطبيعي وألحقها بالمشروع التوسعي الإيراني. كانت إيران تعتبر سوريا حلقة وصل أساسية في مشروعها الإقليمي الممتد من طهران إلى بيروت، وقد دعمت نظام الأسد البائد عسكريًا واقتصاديًا بقوّة لتعزيز هذه الحلقة. إيران التي تلقّت ضربات متتالية في المنطقة، لن تستكين وتسلّم بالهزيمة النهائية في سوريا، وهذا واضح من خلال تصريحات كبار قادتها نزولًا من المرشد إلى قيادات ميدانية في الحرس الثوري، لكنّ فرصتها في العودة باتت شبه مستحيلة الآن.
على الحدود الشمالية تمتلك تركيا حضورًا طبيعيًا كبيرًا مع سوريا، كما لديها علاقات تاريخية متداخلة بشكل كبير تعود إلى الحقبة العثمانية. وقد استقبلت تركيا ملايين اللاجئين السوريين، وتشابكت مصالحها الاقتصادية والسياسية مع هذا البلد. لقد كانت الطموحات التركية الإقليمية، خاصة في عهد أردوغان، كبيرة في سوريا، أوضح عدد من كبار مسؤوليها السياسيين والأمنيين ذلك مستعينين بالميثاق الملي التركي. كانت الهواجس الأمنية من أهم أسباب تدخل تركيا العسكري والسياسي، فدعمت فصائل موالية لها لمنع أي تهديد لأمنها القومي، وحاربت كل المحاولات الكردية لإنشاء إقليم خاص مستقل أو ذي حكم ذاتي.
مع سقوط نظام بشار الأسد أصبحت تركيا اللاعب الأكثر حضورًا وتأثيرًا حتى ولو لم تكن الأوحد. تجلّى هذا بعبارات الرئيس ترامب التي لا تخلو من عمق رغم مبالغتها وسطحيتها الفجّتين، عندما قال بما معناه “إنّ أردوغان استولى على سوريا وهذا ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام”.
جنوبًا، تتابع إسرائيل عن كثب التطورات في سوريا، التي تمثل تهديدًا أمنيًا مباشرًا لها حسب تصريحات كبار قادتها المتتالية. تخشى إسرائيل من تنامي نفوذ الجماعات الجهادية المتطرفة حسب تعبيرات دأبت على استخدامها العقلية الإسرائيلية، كما تخشى من وصول أسلحة متطورة إلى حزب الله، رغمّ أنّ هذه الحجّة الأخيرة أقرب إلى العبث منها إلى المنطق في ظل عقلية القيادة السورية الجديدة ومرجعيتها الفكرية والدينية.
تدخّلت إسرائيل عسكريًا لمنع أي تهديد لأمنها، وهذه ذريعة سخيفةٌ أيضًا لأنّه حقيقة لم يكن هناك أي تهديد استراتيجي لها من قبل سوريا بدءًا من استلام حافظ الأسد السلطة. تسعى إسرائيل بجدّية لإقامة منطقة عازلة على طول حدودها مع سوريا وعلى حساب الأراضي السورية أو المجال الحيوي السوري، وهذا كلّه بانتظار تفاهمات معلنة أو سرية تغزل خيوطها بأناة حينًا وبتهوّر أحيانًا كثيرة، رافعة ذرائع خبيثة وسخيفة أيضًا مثل حماية الدروز أو العلويين.
غربًا، يشكل لبنان خاصرة رخوة لسوريا، ففي ظل هشاشة مؤسساته الموروثة من عقودٍ خلت، وتحت وطأة تزايد حدّة الصراع داخليًا مع حزب الله الحليف الوثيق لإيران، ومع وجود إرادة متصاعدة لتقوية الدولة تجاه الجماعات التي تقاسمتها، يبقى الخطر قائمًا خلال الفترة القادمة. إنّ تعافي لبنان سينعكس بقوّة وبشكل مباشر على استقرار سوريا، وطالما أنّ القيادة السورية الجديدة لديها ما يكفيها من تحديات داخلية الآن، فهي بالتأكيد ستحترم تعهداتها بالقطع مع النهج السابق الذي كان يتعامل مع لبنان بوصفها حديقة خلفية لنظام الحكم السوري.
خليجيًا، تلعب السعودية دورًا محوريًا في التوازنات الجديدة التي برزت بعد سقوط نظام الأسد، وتنطلق من رؤية قيادتها لموقع سوريا في الأمن القومي العربي، ومن تنافسها الإقليمي مع إيران. فبالنسبة للرياض، تمثل سوريا ساحة حيوية يجب ألا تقع تحت الهيمنة الإيرانية مجددًا، وركنًا أساسيًا في خط دفاع عربي جماعي يمتد من الخليج إلى المتوسط. يعتقد كاتب هذه السطور أنّ السعودية ترى في مرحلة ما بعد الأسد فرصة لفرض نهج سياسي واجتماعي جديد، يقوم على دعم القوى السنية المعتدلة، وبناء نموذج محافظ حداثي يشبه التجربة السعودية في “رؤية 2030”.
تسعى الرياض إلى أن تظهر كقوة تحديث عربية، تمزج بين الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، مع الحفاظ على القيم التقليدية والمجتمع المحافظ، ما يشكل بديلًا “متوازنًا” للمشروع الإيراني الثيوقراطي من جهة، والنموذج التركي الحداثوي من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تستخدم السعودية أدوات متعددة لتحقيق هذا الهدف، تشمل الدعم المالي لإعادة الإعمار، الاستثمار في التعليم والخدمات، وربما المشاركة في إعادة بناء المؤسسات السورية بما يتماشى مع رؤيتها للمنطقة، وقد ظهرت بوادر هذه السياسة السعودية جليّة من خلال الدعم الكبير للقيادة السورية في المحافل الدولية كما حصل في اجتماعات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
كانت زيارة الرئيس الأميركي ترامب للرياض قبل أيام، وما نتج عنها من رفع للعقوبات عن سوريا، أكبر تتويج لهذا الجهد السعودي العظيم على طريق إعادة سوريا إلى محيطها ومكانتها الطبيعية في الإقليم.
تتباين مواقف الدول العربية من الصراع في سوريا، فدولة قطر أكثر قربًا من الخط السعودي وكانت زيارة الأمير تميم كأول قائد عربي تخطو قدماه أرض العاصمة السورية بعد هرب الطاغية ذات دلالة بالغة الأهمية، كذلك لا يخفى الدعم السياسي الكبير الذي تقدّمه قطر في المحافل الإقليمية كالعلاقة مع العراق، والدولية كالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية. بينما تميل دول أخرى كالإمارات ومصر إلى الحذر والانفتاح المتأني. هذا الانقسام يعكس تضارب المصالح الإقليمية، ويؤثر على إمكانية بلورة موقف عربي موحد تجاه مستقبل سوريا، وهو واحدٌ من أهمّ التحديات التي تواجه سوريا شعبًا وقيادة جديدة.
إن الوصول إلى سوريا موحّدة ومستقرّة، تتحقق فيها تطلعات شعبها، لا يزال تحديًا كبيرًا للمجتمع الإقليمي، ويحتاج إلى توافق دولي أيضًا، وهو ما سنتحدث عنه في مقالة لاحقة. مع ذلك، لا يمكن للقوى السياسية السورية التعويل فقط على هذه التأثيرات الإقليمية التي تطرقنا إليها أعلاه، لبناء منظومة قيمّ وممارسات ليبرالية وديمقراطية. عليها أن تعمل بالمتاح والمتوفر داخليًا وأن تسعى بكل قوتها لتشكيل جبهة سورية عريضة تضمّ كل القوى الوطنية القادرة على التأثير. مسؤولية القيادة السورية في هذه المرحلة كبيرة جدًا، إنّ انفتاحها على القوى السياسية السورية سيكون عنصر قوّة لها لا عامل تثبيط وإضعاف، ونرجو أن تدرك ذلك وأن تتعامل معه بكل الجدّية الوطنية المطلوبة واللازمة.
تلفزيون سوريا
———————————
الإعلام السوري الجديد.. نقد التقوقع/ عدنان علي
2025.05.24
على غرار بقية القطاعات في الدولة والمجتمع، شهد الإعلام في سوريا حالة من الفراغ وربما الفوضى بعد سقوط نظام بشار الأسد، على نحو يعكس حالة التعطش لدى المجتمع للتمتع بحرية الرأي والتعبير، بعد أكثر من خمسة عقود من السيطرة الأمنية على هذا الإعلام، إذ اعتاد السوريون على إعلام لا يرى ولا يسمع إلا ما يريده الحاكم، ما أفقد الكلمة قيمتها.
وهذا ما بدا واضحاً في الأسابيع والأشهر التالية لسقوط النظام، حيث شهدنا، وما نزال، انفجاراً في حرية التعبير بعد عقود من الكبت، وتعدداً في الأصوات والاتجاهات.
وهذه حالة صحية إلى حد ما، لكنها ترافقت مع حالة من الفوضى الإعلامية، حيث تتنافس جهات متعددة داخلية وخارجية للتأثير في الرأي العام، مع ظهور مئات المنصات؛ بعضها يحمل حساً ثورياً صادقاً، وبعضها مجرد أبواق جديدة بأقنعة مختلفة، وبعضها يحاول العبث والاصطياد في الماء العكر، للتشويش على مرحلة الانتقال السياسي.
ومن المعروف، أنه في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية، غالباً ما تترافق الحرية الإعلامية المفاجئة مع فوضى، وظهور إعلام مضاد، قد يكون بعضه مدعوماً من الخارج، ومنصات تروّج للشائعات أو لأجندات سياسية مختلفة، على نحو ما كشفه مؤخراً تحقيق لقناة “بي بي سي” البريطانية عن وجود ملايين الحسابات التي تُدار من خارج سوريا، خصوصاً من العراق واليمن وإيران ولبنان، وتسعى لبث الكراهية والتحريض على الفتنة في سوريا.
وفي الواقع، إن مهمة كسر القيود قد أُنجزت تقريباً، وبات لدينا هامش واسع من حرية التعبير عن الرأي. غير أن المهمة الأصعب هي بناء الثقة بين الإعلام والمواطن السوري، الذي عانى كثيراً من الأكاذيب والتضليل، ولن يمنح ثقته بسهولة لأي إعلام جديد، إلى أن يثبت صدقه ومهنيته، ويقدم إعلاماً يحترم عقول الناس ويعمل لصالحهم، لا لصالح أية سلطات أو أجندات بعينها.
إذا أُحسن استغلال هذه اللحظة التاريخية، حيث يتوق المجتمع لإعلام صادق يعمل بمعايير مهنية عالية، فقد يصبح الإعلام السوري أداة للمصالحة الوطنية، ومنبراً للضحايا، ومرآة تعكس الحقيقة بكل ألوانها. فالإعلام الحر ليس رفاهية أو شعارات، بل ضرورة لكل بلد يسعى إلى العدالة، والديمقراطية، وبناء دولة المواطنة.
ولا شك أن الإعلام السوري الجديد سوف يحتاج إلى وقت لاستعادة ثقة الجمهور، وبناء مؤسسات مهنية، موضوعية، تحترم قواعد العمل الصحفي، مع بناء بنية قانونية تضمن حرية التعبير وتحمي الصحفيين. وفي هذه الحالة، يمكن أن يلعب الإعلام دوراً مهماً في توثيق الانتهاكات، وسرد روايات الضحايا، وفتح النقاشات المجتمعية حول المصالحة والمساءلة، ما يجعله أداة في عملية التعافي الوطني.
كما يمكن أن يكون أداة فعالة في مراقبة السلطات المختلفة، وتوفير منابر للمختصين من أجل تنبيه تلك السلطات إلى ما يُرتكب من أخطاء أو تجاوزات، خصوصاً في ظل شبه غياب لأدوات الرقابة القانونية على عمل السلطة التنفيذية، بسبب عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة حتى الآن، مثل البرلمان والأحزاب السياسية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الدور المؤثر للإعلام لا بد أن يستند إلى إرادة سياسية واعية، تتفهم أهمية الإعلام في هذه المرحلة، وفي كل مرحلة، ولا تسعى للاستحواذ عليه أو توظيفه في خدمتها فقط، حتى بالنسبة للإعلام المحسوب على الحكومة، بحيث يتم التعامل معه كإعلام دولة، للمواطن والمجتمع حق فيه، وليس مجرد إعلام سلطة، يردد ما تريده دون السماح بالنقد والتقييم.
ما لفت نظر العديد من العاملين في حقل الإعلام السوري هو عدم قدرة القائمين على هذا الإعلام حتى الآن على الانعتاق من “الحالة الثورية” التي عاشوا في ظلها خلال السنوات الماضية، والمحصورة جغرافياً في الشمال السوري، وسياسياً وفكرياً في معاداة نظام الأسد الراحل، دون امتلاك رؤية أوسع لدور الإعلام في مرحلة بناء الدولة الجديدة، سواء على صعيد نقل الحقائق للمجتمع، وهو حق راسخ له، أم تحقيق الوئام الوطني وتخفيف الاحتقان، فضلاً عن مراقبة السلطات المختلفة.
وفي شأن هذا التقوقع حول “الذات” في مجال الإعلام، من الملاحظ أن معظم من تولّى إدارة الإعلام الجديد التابع للدولة هم من الشبان الذين كانوا ناشطين في الشمال السوري، وكانوا يغطون أخبار المعارك، والتقى بهم رئيس الجمهورية أكثر من مرة، بوصفهم “إعلاميي الثورة”، دون أن يلتقي بغيرهم من الإعلاميين، ما يشير إلى فهم غير مكتمل لمفهوم الإعلام ومفهوم الثورة، بحيث يكاد ينحصر جغرافياً في منطقة معينة، وينحصر سياسياً في إطار ضيق، هو مجموعة الموالين للسلطة. ولنتصور مثلاً كيف تكون النتيجة لو طُبق هذا المفهوم على بقية القطاعات، كأن نقول “محامو الثورة” أو “مهندسو الثورة” أو “أطباء الثورة”، بمعنى أن يُستبعد كل شخص من هؤلاء لم يكن موجوداً في إدلب ومحيطها خلال السنوات الماضية.
إنّ ثمة إعلاميين كانوا معارضين للنظام حتى قبل أن تكون هناك ثورة في سوريا، وهؤلاء دفعوا أثماناً كثيرة بسبب مواقفهم، وبعضهم غادر الإعلام المحلي في وقت مبكر من قيام الثورة بسبب المضايقات والتهديدات التي تعرضوا لها، وعملوا في وسائل إعلام عربية ودولية مرموقة.
والآن، لا يتم الاعتراف بهم لا بين الإعلاميين ولا بين الثوريين، وتُترك الساحة فقط للناشطين الإعلاميين، وكثير منهم لا يملكون التأهيل الكافي، ليس لتولّي مسؤوليات في الإعلام، بل حتى لممارسة عمل إعلامي محترف.
من المنطقي تشجيع الشباب على أخذ فرصتهم في الإعلام وفي غيره من المجالات، لكن بعد تأهيلهم واكتسابهم بعض الخبرة. ومع هذا “التفكير الإقصائي” الذي قد تظهر نتائجه السلبية عما قريب، يصبح لزاماً طرح تساؤلات عمّن يدير الإعلام حقيقة، وما مدى “حصة” وزارة الإعلام في هذه الإدارة، خصوصاً مع بروز أقاويل عن وجود “مراكز قوى” أو “دولة عميقة” تتحكم بالإعلام، كما بغيره، سواء في الإدارة السياسية أو وزارة الخارجية أو الأجهزة الأمنية، تماماً على نحو ما كان يحصل في دولة الأسد، حيث كان الإعلام يُدار بهذه الطريقة أيضاً.
من المفارقات التي رواها أحدهم أمامي، وهو يقدم نفسه كشيخ عشيرة، أنه حصل على وظيفة كمحرر في قناة “الإخبارية السورية” عن طريق تزكية من أحدهم، لكنه تراجع عن قبولها بعد أن اتصل به مسؤول أمني، ووعده بوظيفة أفضل. وطبعاً، هذا يحدث فقط حين لا تكون هناك إدارة مهنية للإعلام.
تلفزيون سوريا
—————————————–
الإشاعة حقيقة والحقيقة إشاعة/ أسامة إسبر
24 مايو 2025
نعيش في زمن الشائعات. تأتي الأخبار من مصادر مختلفة، وبتدفّقٍ غير مسبوق يسبّب إرباكاً حقيقياً. نشككّ بكلّ ما نسمعه ونراه بسبب تعدّد الرواة والمصادر. هذا ما دفع الفيلسوف الفرنسي جاك إلول (1912- 1994) إلى القول إن الدعاية المعاصرة لا تعتمد على الأكاذيب فحسب، بل على إغراقنا بالمعلومات المتناقضة، فتتفكّك الحقيقة نفسها، وتتحول إشاعةً لا يمكن التحقّق منها. ذلك أن وسائل الإعلام تضخّ كمّاً هائلاً من التفسيرات والتأويلات تشوّه الوقائع وتنصّب الانطباعات الشخصية وإملاءات العواطف على كرسي المعايير المعرفية. في جوّ مثل هذا، يمكن القول عن “اختطاف” الفتاة السورية ميرا جلال ثابت، ثم ظهورها عروساً سعيدةً، إنه جرى ولم يجرِ. هناك سرديات تؤكّد “الاختطاف” وأخرى مضادّة تنفي. رواة يتبعون الخطاب الرسمي وآخرون يعارضونه، ولكلٍّ منهم قصّته عن ميرا جلال ثابت، التي أشيع أنها اختُطفت من معهد أتت إليه كي تقدّم الامتحان، واختفت فيما كان والدها ينتظرها خارجه.
بعد انتشار القصة وظهور ميرا في نقاب غريب عن بيئتها، سمعنا روايةً مختلفةً تناقلها إعلاميون كثيرون، قالت إن ما جرى لم يكن إلا قصّة حبّ. بين روايتَين، واحدة تؤكّد السبي وشرعنته، وأخرى تنفيه وتصوّر الاختفاء هرباً رومانسياً لفتاة مع حبيبها، ضاعت حقيقة ما حدث لميرا، ليس لأن الرواية الأولى صادقة والثانية كاذبة أو العكس، بل لأن المرأة في مجتمعنا لا تستطيع أن تروي قصّتها.
نعيش في جو تُحوَّل فيه الإشاعةُ حقيقةً والحقيقةُ إشاعةً. في مناخ كهذا، لا حاجة لأن تنطق، ثمّة من ينطق عنك أو يُنطِقكَ، ثمّة من يُفسّر تعابير وجهكَ ويدرس ملامحكَ كي يتوصّل إلى استنتاجاته الخاصّة. قد تكون في مقابلة غاضباً مكتئباً، وفي أخرى ضاحكاً سعيداً، ويتم البناء على ذلك. غير أنه في هذه المقابلات يُغفَل السياق، ويُركّز في تفاصيل مثل العبوس أو الضحكة أو آثار القيد على اليد أو وشم يحمل اسم الحبيب. ومن هذه التفاصيل تُبنى سرديات تصنع الرأي العام. لا يهم إن كنتَ تكذب أو تقول الحقيقة، ما يهم هو أنك صرت موضوعاً للإعلام، الذي يُسوِّقكَ كذبةً أو حقيقةً. تزدهر الشائعات وتتسيّد المشهد العام، بحسب عالم الاجتماع الفرنسي جان نويل كابفيرر، صاحب كتاب “الشائعات… الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم” (نقلته إلى العربية تانيا ناجيا، دار الساقي، بيروت، 2007)، في بيئات تنهار فيها الثقة بالمؤسّسات الحكومية. فعندما تفقد الهيئات القضائية والصحافة والمؤسّسات التعليمية مصداقيتها في نظر الناس ينشأ فراغ في السلطة والمعلومات الموثوقة. في هذا الفراغ يلجأ الأفراد إلى شبكاتهم غير الرسمية من أصدقاء وأقارب، وإلى منصّات التواصل أو مصادرَ مجهولةٍ للبحث عن تفسير أو خبر. إلا أن هذه المصادر تفتقر إلى آليات التحقّق والتدقيق، ما يتيح للشائعات الانتشار بلا ضوابط. وكلّما تراجعت الثقة في المصادر الرسمية، ازداد الاعتماد على الروايات العاطفية أو المتخيّلة، التي “يُراد لها أن تكون صحيحةً”، حتى إن كانت زائفةً.
في الحالة السورية، لا نضع في الحسبان غياب الديمقراطية وسلطة القانون. لا نناقش غياب القضاء النزيه، ولا يُطرح السؤال عما إذا كانت المرأة في زمن الذكور، تمتلك استقلاليتها أو قدرتها على الجهر بما يدور في ذهنها، في جوّ تسوده ثقافة الشرف والعرض. يفتح التضارب بين الروايتَين حول حقيقة ما حدث لميرا باباً لسؤال فلسفي قديم متجدّد: ما هي الحقيقة؟… بحسب نظرية التطابق، الحقيقة هي ما يتطابق مع الواقع. لكنّنا (قرّاءً أو مشاهدين) لا يمكننا أن نصل إلى ميرا كي نستمع إليها في بيئة مستقلّة. هل نثق بمن يروي عنها؟ وعلى أيّ أساس؟ فالحقائق تصلنا عبر وسطاء، وهنا يكمن الخطر: في زمن السوشيال ميديا يطيح التأثير الصدق، ويُصبح انتشار القصّة معياراً لصحّتها. وتتعقّد المسألة أكثر في ظلّ التطوّر الهائل والمتسارع للذكاء الاصطناعي، إذ يمكن تزييف كلّ شيء وتقديمه حقيقةً.
انهار الخطّ الفاصل بين الحقيقة والكذب. لم يعد الإعلام يكتفي بالكذب، بل يعيد تصوير الواقع بطريقة تجعل الكذب يبدو منطقياً، كما تفعل الأنظمة الشمولية، في وصف حنّة أرندت لها. صارت الحقيقة تُنتَج داخل منظومات السلطة، أو بيد من يدورون في فلكها. لكنّ المنظومات التي تعمل في الواقع السوري هي “شبه سلطة” و”شبه ثقافة” و”شبه معارضة”، مشاريع غير مكتملة. ما اكتمل هو انقسام السوريين طائفياً، إذ تصبّ معظم السرديات في الإعلام الاجتماعي في مجرى طائفي. في سياق كهذا، لا يهمّ احتمال تفكّك سورية، ولا تسريح الموظّفين، ولا القتل خارج إطار القانون، ولا الفقر المتفاقم، ولا حتى تجدّد الرغبة في مغادرة البلاد كما كان الأمر في عهد بشّار الأسد. ما يهمّ هو فحولة السرد الإعلامي، وامتلاك هذه الفحولة على حساب كلّ شيء آخر.
تختبر قصّة ميرا الواقع السوري، وتكشف أن من يملك وسائل الإعلام يمتلك الحقّ والقدرة على تحديد ما هو “حقيقي”. ففي ظلّ المنصّات الرقمية تُعيد الخوارزميات تدوير الروايات الأكثر إثارة ويُصبح التكرار وسيلةً لصنع الحقيقة. ما يتم تداوله بكثرة يُصدَّق، حتى لو كان مفبركاً. يُشار إلى هذا باسم “تأثير الحقيقة الوهمية”، الذي يحدث عندما تتكرّر الكذبة، حتى تصبح مألوفةً، ثمّ يتم التعامل معها كأنّها واقع. هـذا ما تحدّث عنه جان نويل كابفيرر، حين قال إن الشائعات تزدهر عندما تنهار الثقة بالمؤسّسات الرسمية. فهي نظام موازٍ للمعرفة، يتم الاعتماد فيه على العاطفة والتكرار لا على الدليل والمنطق، وبالتكرار تصبح الكذبةُ مألوفةً. في خضمّ هذا الضجيج يُدفن صوت الضحيّة تحت العناوين الجذّابة، والعبارات العاطفية، أو يعاد إنتاجه سرديةً مزّيفةً. والسؤال الأكثر أهميةً هنا: هل تستطيع ميرا في ظلّ هذا الواقع أن تكون نفسها؟ هل تمتلك الجرأة على قول الحقيقة؟ فالإعلام يصوّرها في وضعيات قابلة للتأويل، لكنّه لا يعبّر عن واقعها، بل يصنع سردياته الخاصّة، ويعيد إنتاجها بلا نهاية. لذلك لا يمكن لقصّة ميرا أن تكون مهمّةً، إلا إذا فُهِمت في سياق الثقافة السورية التي تمتح من موروث لا يمنح المرأة استقلاليتها، ولا يُمكّنها من قول الحقيقة. وحين يسود القانون في سورية، وتصبح المواطنة واقعاً ملموساً، وتتحرّر المرأة، ويُكتَب هذا في الدستور، عندها ستكون ميرا قادرةً على أن تقول لنا الحقيقة، هي وغيرها من الضحايا.
انطلاقاً ممّا سبق، يمكن القول إن السماح للكذب بأن يُعامل وجهةَ نظر، لا يؤدّي إلا إلى المزيد من التشوش والضبابية. وعندما يُفرّط الإنسان بالحقيقة، لا يخسر جولةً في نقاش إعلامي أو ثقافي فحسب، بل يخسر جوهره الإنساني. إذ إنّ تحويل الحقيقة إشاعةً والإشاعةُ حقيقةً، ليس مجرّد خلل في الإدراك أو تضليل عابر، بل هو سلاح سياسي فعّال، يُستخدم لتقويض الوعي الجماعي وبثّ الشكّ وتفكيك السرديات التي تهدّد بنية السلطة ومصالحها. وفي مجتمعات منقسمة، ومهيّأة للتضليل، يصبح الدفاع عن الحقيقة فعلاً أخلاقياً نبيلاً، لأن التآمر عليها (الحقيقة) لا يُهدّد المعرفة فحسب، بل يهدم أيضاً حلمنا بإمكانية بناء مستقبل مشترك.
العربي الجديد
———————————–
لماذا وحدتهم الوطنية مُقدسة ووحدتنا مُدنسة؟/ د. فيصل القاسم
24 أيار 2025
في عام ألفين واثنين فقدت الوزيرة البريطانية آن وينترتون منصبها كمتحدثة باسم رئيس حزب المحافظين لشؤون الزراعة بسبب نكتة سخيفة. فقد تهكمت الوزيرة أثناء تناولها الغداء مع مجموعة من الأصدقاء والصحافيين في أحد الأندية الرياضية على إحدى الجاليات الأجنبية في بريطانيا. وكانت النكتة على الشكل التالي: «هل تعلمون لماذا رمى شخص إنكليزي مهاجراً من الجالية الفلانية من نافذة القطار وهو مسرع، لأن كل عشرة منهم في بريطانيا يساوون بنساً (فلساً) واحداً». لم تكن تدرك سعادة الوزيرة أن تلك النكتة السمجة ستصل إلى الإعلام وستطردها من الحكومة، فقد تقصد أحد الصحافيين الذين كانوا يتناولون الغداء مع الوزيرة، نشر النكتة التي روتها الوزيرة، وبعد ساعات فقط من وصول النكتة إلى وسائل الإعلام كان رئيس حزب المحافظين إيان دنكين سميث وقتها على الهاتف ليطلب من الوزيرة تقديم استقالتها فوراً، وإذا لم تفعل فوراً، فسيخرج هو على الملأ ليطردها بنفسه. وقد برر سميث قراره السريع والحاسم بأنه يُمنع منعاً باتاً التلاعب بالنسيج العرقي والطائفي والاجتماعي في بريطانيا. أو بعبارة أخرى فإن الوحدة الوطنية في البلاد خط أحمر لا يجوز لأحد تجاوزه مهما علا شأنه، وأن أي مس به سيعرّض صاحبه لأقسى العقوبات.
وقد سنت الحكومة البريطانية وغيرها من الدول الأوروبية قوانين صارمة جداً لمكافحة العنصرية والطائفية والتحزب العرقي والديني، بحيث غدا النيل من الأعراق والطوائف والإثنيات والديانات في البلاد جريمة يُعاقب مرتكبها عقاباً أليماً، فالشحن الطائفي والعرقي والإثني والمناطقي والديني ممنوع منعاً باتاً في الغرب، وأن أي محاولة لشق الصف الوطني أو إضعاف التلاحم الاجتماعي جريمة لا تغتفر في الأقاليم الغربية. إن الوحدة الوطنية في أوروبا وأمريكا شيء مقدس، والويل كل الويل لمن يحاول التلاعب بها.
لقد حاولت الحركات الانفصالية في أوروبا كثيراً الاستقلال، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وغيرها. فبالرغم من لجوء منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى العنف لعدة عقود من أجل فصل إيرلندا الشمالية عن بريطانيا إلا أنها لم تنجح، وقد وجدت نفسها مضطرة أخيراً للتفاوض مع التاج البريطاني والتخلي حتى عن سلاحها. صحيح أن منظمة الباسك الإسبانية ما زالت تحاول الانفصال، لكن الحكومة الإسبانية لن تحقق لها مرادها. وكذلك الأمر بالنسبة للكورسيكيين في فرنسا. ولا ننسى أن هناك ولايات أمريكية تسعى منذ زمن بعيد للاستقلال عن واشنطن كولاية كالفورنيا، لكن الاستقلال ما زال حلماً بعيد المنال بالنسبة لها.
لكن في الوقت الذي تحافظ فيه الدول الغربية على نسيجها الوطني واللحمة الداخلية وتحميهما من التفكك بضراوة عز نظيرها نجد أن التلاعب بالوحدة الوطنية في بلادنا أسهل من شرب الماء. وعلى ما يبدو أن هناك أيادي خارجية تريد أن تطبق النموذج العراقي التفكيكي على الشعب السوري، فبدل أن يستمتع السوريون بهذا النصر التاريخي على أعتى عصابة حكمت البلاد، راح البعض يثير الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية، ويحرض المكونات السورية على بعضها البعض، فامتلأت مواقع التواصل بالمحرضين والمؤججين. صحيح أن تحقيقاً لهيئة الإذاعة البريطانية قد أظهر أن هناك جهات خارجية أغرقت مواقع التواصل بمنشورات طائفية لتأليب السوريين على بعضهم البعض ودق الأسافين بينهم، إلا أن بعض السوريين من كل الأطراف، أو الذين يمكن أن نسميهم بأعوان الذباب الإلكتروني، شاركوا ومازالوا يشاركون في هذه الحملة الشيطانية لضرب الوحدة الوطنية وتحويل النصر إلى وبال على السوريين وإثارة البلبلة في الشارع السوري بهدف تفريق السوريين وبالتالي الدفع في اتجاه تفتيت البلد.
إن الشبيحة الجدد من كل المكونات السورية بكل فئاتهم وألوانهم وتوجهاتهم يهددون النسيج السوري، وإذا كان من الصعب وضع حد للذباب الإلكتروني الخارجي، فمن السهل إيقاف الشبيحة والمحرضين الجدد في الداخل والخارج من كل المكونات السورية عند حدهم لأنهم معروفون للجميع ويشكلون خطراً على كل السوريين دون استثناء شعباً وحكومة. ضعوا حداً لهؤلاء أينما كانوا ومن أي مكون سوري كانوا، وكفاكم تساهلاً مع المحرضين من كل المكونات السورية، ففي أحيان كثيرة تكون المصلحة الوطنية أهم من حرية التعبير بألف مرة، لهذا فلتصدر قوانين ساحقة ماحقة في سوريا لتجريم كل الذين يستغلون حرية التعبير للشحن الطائفي ونشر الكراهية وإثارة الفتن وزرع الشقاق بين السوريين. اضربوا بيد من حديد على المحرضين من كل المكونات السورية. لا تستثنوا أحداً كائناً من كان، اقمعوهم بكل الوسائل، أخمدوا أصواتهم بكل الأدوات والطرق المشروعة ولا تتساهلوا مع أحد. ولتكن العقوبة سجناً مؤبداً وأعمالاً شاقة، وإلا فإن سوريا ستذهب، لا سمح الله، الى صراعات لن تبقي ولن تذر.
إن أوطاناً تسكن على هذا الصفيح الساخن الطائفي البغيض وهذا التنوع العرقي الكثير، لا بد لها من انتهاج سبيل قويم غير ذلك الطرح العليل من تأجيج النيران وإثارة النعرات، وإيجاد كافة السبل للم شمل الأوطان وتوحيدها وتعزيز لحمتها لا توتيرها وتجييشها الذي سيذهب بالجميع إلى الجحيم. ومن هنا كانت القوانين المتشددة في الغرب حيال هذا الموضوع الحيوي والهام الذي يجب أن يبقى حصيناً وبعيداً عن متناول العباد.
وفي الوقت الذي نحيي فيه الآخرين على غيرتهم العظيمة على وحدتهم الوطنية نناشدهم ألا يعبثوا بوحدتنا وأن يتوقفوا عن ألاعيبهم التقسيمية الشيطانية التي دفعت الشعوب ثمنها من استقرارها، ودمائها، وخبزها وحريتها.
كما نناشد مثقفينا وإعلاميينا ومعارضينا وسياسيينا أن يتعلموا من الدول الغربية التي تدافع عن وحدة بلادها بالحديد والنار، وهي على حق، فلا قيمة لأوطان تسكنها طوائف وملل ونحل وقبائل وبطون وأفخاذ متناحرة وتنام وتصحو على الصراعات الطائفية والدينية والعرقية القاتلة وتمضي وقتها بالتهديد والوعيد، وتلهي نفسها بثقافة التخوين والتكفير.
القدس العربي
———————————
انهيار النظام العربي أم إرهاصات لولادة نظام جديد/ حسن نافعة
24 مايو 2025
سعى النظام العربي الرسمي (منذ تأسيسه) إلى تحقيق هدفَين رئيسَين: الوحدة العربية والتصدّي للمخطّطات الصهيونية في المنطقة. صحيحٌ أن الفِكَر الداعية إلى الوحدة العربية أسبق في نشأتها على تلك الداعية إلى مقاومة المخطّطات الصهيونية، غير أن عوامل عديدة أسهمت في الربط عضوياً بين الهدفَين، من أكثرها أهميةً فشل الثورة العربية الكبرى، التي سعت إلى توحيد دول المشرق العربي، وانكشاف التواطؤ البريطاني مع مطالب الحركة الصهيونية على حساب المطالب العربية، وسقوط الخلافة الإسلامية وتفكّك الإمبراطورية العثمانية، لتقع معظم الأقطار العربية تحت سلطة الاحتلال الأوربي المباشر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كما اندلاع عديد من الثورات الفلسطينية المتعاقبة بين الحربَين، أسهمت في تعميق وعي النُّخب العربية بأنّ الأطماع الصهيونية لا تقتصر على فلسطين وحدها، إنما تستهدف الإبقاء على العالم العربي مقسّماً، والعمل على تفتيته أكثر كي تسهل السيطرة عليه. وتفسّر هذه العوامل المتداخلة لماذا تزامنت ولادة النظام العربي الرسمي بتأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، مع تصاعد حدّة الصراع الدائر في الساحة الفلسطينية، وتعميق الشعور السائد لدى معظم النُّخب السياسية والفكرية في العالم العربي بأنّ القضية الفلسطينية ينبغي أن تكون “قضيةَ العرب الأولى”، وهو الشعار الذي ما زالت أصداؤه تتردّد في جميع مؤتمرات القمّم العربية، على الرغم من أنه أُفرِغ من مضمونه.
مرّ النظام الرسمي العربي بمراحل تطور متعدّدة، فرضتها ضرورات التأقلم مع الأوضاع العالمية والإقليمية المتغيّرة، حاول خلالها تحقيق الأهداف التي قام من أجلها، لكنّ منجزاته كانت ضحلةً إلى حدّ كبير، سواء على صعيد العمل الوحدوي، أو على صعيد مقاومة المخطّطات الصهيونية في المنطقة، لأنه لم يستخدم المنهج العلمي، واتسمت مواقف النظام وتصرّفاته بالتخبّط والعشوائية وعدم وضوح الرؤية، والعجز عن اختيار الوسائل التي تتناسب مع الأهداف المنشودة. فعلى صعيد السياسات التي استهدفت تحقيق الوحدة بين أقطاره المختلفة، خاضت الدول العربية تجاربَ وحدويةً عديدةً، صمد بعضها فترةً وجيزةً، ثمّ انتكس وانهار، مثل نموذج الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية، وظلّ معظمها مجرّد حبر على ورق، لم يدخل حيّز التنفيذ، كمشروعات التكامل بين مصر وليبيا والسودان، ومشروعات الوحدة بين مصر وسورية والعراق وغيرها. النموذج الوحيد الذي أفلت من الفشل هو النموذج الإمارتي، الذي نجح في تحقيق وحدة مستدامة بين “إمارات متصالحة”، لكنّه محدود التأثير، وغير قابل للمحاكاة والتعميم على مستوى النظام ككل. والواقع أننا إذا ألقينا نظرةً فاحصةً على النظام العربي بوضعه الحالي، من منظور وحدوي، فسوف نجد أنه لم يفشل في تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية فحسب، ولكنّه فشل أيضاً في المحافظة على وحدة واستقلال الدولة الوطنية، التي تفتّت عدد منها إلى دويلات أصغر، كالسودان والصومال وغيرهما، واشتعلت الحروب الأهلية في بعضها الآخر.
على صعيد السياسات التي استهدفت إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، والتصدّي لمخطّطاته التوسّعية، كانت الحصيلة فشلاً أكبر، فقد خاضت الدول العربية حروباً نظاميةً عديدةً في مواجهة الكيان الصهيوني، لكنّها هُزمت في معظمها، ولم تنجح جزئياً إلا في حرب 1973. وحين قرّرت مصر أن تكون تلك الحرب آخر الحروب، بدأت نهج التسوية السياسية، وسلكته منفردةً، ولم ينجح هذا النهج، لا في إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية ولا في تحرير الأراضي العربية المحتلّة كلّها. وأفضى ذلك إلى تعميق الخلافات العربية وانقسام النظام العربي بين معسكرَين، أحدهما يدفع في اتجاه التسوية السياسية، والآخر يدفع في اتجاه المقاومة المسلّحة، وكلاهما عاجز عن تحرير جميع الأراضي العربية المحتلّة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة، وفق القواعد التي استندت إليها المبادرة التي طرحتها السعودية، وأقرّتها القمّة العربية عام 2002 في بيروت. أفضى ذلك أيضاً إلى اختفاء ظاهرة الحروب النظامية، وانتقال إدارة الصراع المسلّح إلى أيدي فاعلين من غير الدول، وظهور “محور مقاومة”، تقوده إيران وتشارك فيه فصائل عربية مسلّحة، فلسطينية وغير فلسطينية. كما مهّد الطريقَ أمام “طوفان الأقصى”، التي اتخذ منها الكيان الصهيوني ذريعةً للقيام بحرب إبادة جماعية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى كلّ من سيناء والأردن، وما تزال مستمرّة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لا يتّسع المجال هنا لتحليل تفصيلي لمجمل الأسباب التي أدّت إلى إخفاق النظام العربي الرسمي في تحقيق أيّ من الأهداف الكُبرى، التي كانت (وما تزال) تبرّر وجوده. غير أن في وسع الباحث المتتبع للمسار الذي سلكه هذا النظام أن يصل إلى نتيجة مفادها بأن قدرته على الإنجاز مرهونة بتوافر شرطَين متلازمَين: قيادة مؤهّلة وفاعلة، فرديةً كانت، كدور مصر الناصرية في بعض المراحل، أو جماعية، كأدوار مصر وسورية والسعودية في مراحل أخرى. وتسلّح هذه القيادة، فرديةً أم جماعيةً، بإرادة مصمّمة على مواجهة التحدّيات كافّة، خصوصاً التي يفرضها تمدّد المشروع الصهيوني، بكل السبل المتاحة، بما فيها الوسائل العسكرية. ولأن أيّاً منهما ليس متاحاً في الوقت الراهن، بدليل ما جرى إبّان زيارة الرئيس الأميركي ترامب أخيراً السعودية وقطر والإمارات، والقمّة العربية التي تلتها في بغداد، يمكن القول إن النظام العربي الرسمي بات آيلاً للسقوط والانهيار التام.
ترامب هو الرئيس الأميركي الذي اعترف بالقدس الموحّدة عاصمةً أبدية لإسرائيل، ونقل إليها السفارة الأميركية، ولا يمانع في توسيع المستوطنات وضمها لإسرائيل، ويشارك فعلياً في حرب إبادة جماعية تُشنّ على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام ونصف العام، ويعبّر علناً عن رغبته في تهجيرهم قسراً من وطنهم. وكان مشهد هذا الرئيس (ترامب) وهو يفاخر بحصوله من الدول الثلاث على استثمارات بنحو خمسة تريليونات دولار، مستفزّاً. لو أن هذه الدول استطاعت أن تحصل من ترامب على التزام بوقف الحرب، أو على وعد بالامتناع عن استخدام حق النقض (فيتو) لحماية إسرائيل من العقاب، أو على اعتراف بحقّ الفلسطينين في إقامة دولة مستقلّة في حدود 1967، لهان الأمر. ويثير الانتباه والاستغراب هنا أن هذه الدول تبدو غير قادرة حتى على التنسيق فيما بينها لتعزيز مواقفها التفاوضية تجاه الولايات المتحدة، لأن كلّ ما يعنيهم هو تلبية احتياجاتهم الثنائية، مع أن بمقدورهم الحصول على أفضل بكثير ممّا حصلوا عليه لو سعى الجميع إلى تبنّي استراتيجية مشتركة لإدارة العلاقة مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.
انعقدت في اليوم التالي لمغادرة ترامب قمّة عربية في بغداد، لم يشارك فيها (على مستوى الرؤساء والملوك) سوى زعماء خمس دول فقط، واكتفت البقية بالمشاركة بوفود على مستوى تمثيل أقلّ. وأيّاً كان الأمر، لم يختلف البيان الختامي الذي صدر في “القمّة” عن كلّ البيانات الختامية التي صدرت في القمم السابقة، والتي عادةً ما تعجّ بعبارات إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع. وتكفي مقارنة بسيطة بين ما جرى في الرياض والدوحة وأبوظبي، بما جرى في بغداد خلال الأسبوع الماضي، لندرك الوزن الحقيقي للقمم العربية في جدول اهتمامات الدول العربية. كما يكفي أن نقارن ما جرى في هذه العواصم العربية بما يجري حالياً في قطاع غزّة، لندرك مدى انحدار النظام الرسمي العربي، فعند معبر رفح ما تزال آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء تنتظر في صفوف طويلة، لكنّها لا تستطيع التحرّك قيد أنملة لإنقاذ شعب أعزل جائع من براثن نظام عنصري تفوق في وحشيته وإجرامه على النظام النازي نفسه.
أليس من المفارقات أن تتزامن زيارة ترامب للدول العربية الثرية في الخليج، ثمّ انعقاد القمّة العربية في بغداد، مع الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين الأولى. فكم من نكبة جديدة ينتظرها النظام الرسمي العربي ليستيقظ من سباته! ألم يحن الوقت بعد كي تعترف الدول العربية بأن النظام الرسمي الذي أسّسته عام 1945 سقط وانهار بالفعل؟ وأن الحاجة باتت ماسّةً إلى نظام عربي جديد قادر على تحقيق درجة أرقى من التكامل العربي، وعلى مواجهة التحدّيات التي يفرضها الكيان الصهيوني، التي لن تستطيع أيّ دولة عربية أن تواجهها بمفردها؟
العربي الجديد
—————————–
سوريا للجميع: دروس من الماضي/ نوار نبيه جرادة
23/5/2025
في مراحل متعددة من تاريخها الحديث، مرّت سوريا بتحولات سياسية واجتماعية أثرت بشكل مباشر في بنية الدولة والمجتمع.. واليوم، ومع استمرار تعقيدات المشهد السوري، تبرز الحاجة إلى مراجعة التاريخ بعين نقدية تساعد في فهم الحاضر، وتجنّب تكرار الأخطاء السابقة.
تهميش الأرياف وبداية التشكل السياسي
خلال الحقبة الإقطاعية، عانت مناطق واسعة من سوريا -خصوصًا في الأرياف- من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. شمل ذلك فئات مختلفة، من العلويين في الساحل، إلى الدروز في السويداء، والفلاحين في الجزيرة ودرعا وريف دمشق. ضعف الخدمات، وغياب البنية التحتية، وتراجع فرص التعليم والعمل، عوامل ساهمت جميعها في تأزيم الفجوة بين الريف والمدينة.
هذا التفاوت في التنمية ساعد على تشكيل وعي سياسي جديد في صفوف أبناء الأرياف، خصوصًا مع ظهور الحركات القومية واليسارية التي رفعت شعارات العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاحتكار السياسي.
صعود فئات مهمشة إلى السلطة
في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وجدت فئات مهمشة، منها أبناء الطائفة العلوية، في الأحزاب العقائدية -مثل حزب البعث- أداة لتحقيق طموحاتها السياسية والاجتماعية. تزامن ذلك مع انقلابات عسكرية غيّرت من طبيعة السلطة في سوريا. وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963 شكل نقطة تحول، إذ بدأت النخب الجديدة القادمة من الريف تتولى مناصب قيادية في الدولة.
لكن هذه التحولات لم تخلُ من إشكاليات، إذ انتقل مركز السلطة من طبقة إلى أخرى، دون بناء نظام مؤسساتي يضمن تداول السلطة ويفرض الشفافية والمساءلة.
إعادة إنتاج الإقصاء: خطر متجدد
بدءًا من عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتعرّي بنية الدولة والمجتمع، ظهرت مجددًا خطابات تدعو إلى إقصاء جماعات بعينها على خلفيات سياسية أو طائفية.
هذه الأطروحات لا تختلف جوهريًا عن السياسات التي ساهمت في تكريس التهميش وإنتاج دورات متتالية من الصراع في العقود السابقة. فكل مشروع سياسي يعتمد على الإقصاء بدل الشمول، وعلى التصنيف بدل المواطنة، إنما يؤسس لمزيد من الانقسام، لا للاستقرار.
التجارب السابقة، سواء في فترات الانتداب الفرنسي أو بعد الاستقلال، أظهرت أن التمييز بين المواطنين يؤدي إلى نتائج كارثية تقوّض الوحدة الوطنية.
باتجاه مشروع وطني جامع
بناء دولة مستقرة يتطلب اتفاقًا وطنيًا واسعًا يعترف بتعدد الهويات، ويرتكز على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وهذا المفهوم ليس تنظيرًا سياسيًا، بل ضرورة واقعية لضمان بقاء الدولة. تجارب دول أخرى أظهرت أن تجاوز الانقسامات لا يكون عبر المحاصصة، بل عبر بناء مؤسسات تحكمها معايير قانونية عادلة.
إرساء هذا النهج في سوريا يحتاج إلى مراجعة خطاب النخب السياسية والثقافية، وتبنّي خطاب جامع بعيد عن التجييش أو الاستقطاب.
بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار
نحو عقد اجتماعي جديد
الاستفادة من دروس الماضي تقتضي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التوافق.. سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على عقد اجتماعي جديد، يضع المواطنة فوق أي اعتبار طائفي أو مناطقي، وإن أي محاولة لإعادة إنتاج الإقصاء أو الاحتكار السياسي ستؤدي إلى دورات صراع متكررة.
بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
خريج كلية حقوق دمشق و كلية العمل المجتمعي ألمانيا
الجزيرة
————————————-
ضحايا العنف الطائفي بالذاكرة.. مبادرة سورية للسلام من جرمانا/ شام السبسبي
24/5/2025
دمشق- أقامت مبادرة “الطائفة السورية”، بالتعاون مع هيئات ومنظمات أهلية من مدينة جرمانا، نقاشا مفتوحا بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والوطنية، استكمالا لجهودها في تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك بين السوريين.
واستهل وفد المبادرة اللقاء، الذي عُقد أمس الجمعة في صالة أفراح بمدينة جرمانا شرقي العاصمة دمشق، بتقديم العزاء لأهالي الضحايا الذين قُتلوا في الاشتباكات التي شهدتها المدينة نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وعبر مدير المبادرة منذر رساس عن حزنه الشديد إزاء “الأحداث الأمنية المؤسفة” التي وقعت في المدينة، متمنيا أن تكون الأخيرة من نوعها، معتبرا أن “جرمانا تمثل نموذجًا مصغرا لسوريا، ولا يليق بها ما حدث”.
وكانت جرمانا قد شهدت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية وجهة مسلحة مجهولة حاولت اقتحام المدينة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من الأمن العام و6 من أبناء المدينة، وذلك عقب انتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسب خطأ إلى أحد مشايخ الطائفة الدرزية.
نبذ الطائفية
وشارك في النقاش المفتوح عدد من أعضاء المبادرة إلى جانب أهالي الضحايا، ومشايخ ووجهاء المدينة، بحضور رئيس البلدية وهيب حمدان.
وتناول النقاش عدة محاور، أبرزها أحداث جرمانا الأخيرة وأثرها على التماسك الاجتماعي في سوريا، وتصاعُد الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المشاركون ضرورة نبذ الطائفية في سوريا، وأهمية التمييز بين “الطائفة الأسدية” التي ارتكبت جرائم بحق السوريين في إشارة إلى فلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، و”الطائفة السورية” التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرات الأهلية في إرساء السلم الأهلي، لا سيما في المناطق التي شهدت توترات أمنية.
من جهته، قال المحامي والناشط المدني كمال الخطيب، أحد المشاركين في النقاش ومن أبناء جرمانا، إن مبادرة “الطائفة السورية” تعبّر عن تطلعات السوريين نحو مستقبل قوي ومزدهر بعيدا عن الطائفية والمناطقية.
وأضاف الخطيب، في حديثه للجزيرة نت، أن الشعب السوري بطبيعته محب وحاضن لجميع مكوناته، مستشهدا بتاريخ طويل من التعايش في مدن مثل دمشق وحلب والسويداء واللاذقية، مؤكدا أن سوريا كانت ولا تزال منيعة أمام التطرف، ولديها خبرة متجذرة في التعايش المشترك.
المواطنة الفاعلة
أما منذر رساس، مدير المبادرة، فلفت إلى أن فكرتها انطلقت من توافق بين عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، التي رأت أن ضعف التماسك الاجتماعي يمثل أحد أبرز التحديات الحالية.
وأوضح رساس -في حديثه للجزيرة نت- أن هناك حاجة ملحة لتفعيل مفهوم “المواطنة الفاعلة”، مضيفا أن “توحيد الشعب ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل إنه واجب جماعي يجب أن يتحمله المجتمع بأكمله، وهو ما تسعى مبادرتنا لتحقيقه”.
وتابع قائلا “بعض القضايا لا تحل بالقوانين فقط، بل تتطلب تغيير الصور النمطية والانفتاح على الآخر، وكسر الحواجز النفسية، ومد الجسور بين أبناء الوطن”.
وأشار إلى أن المبادرة حرصت على الحضور في مختلف المناطق السورية، من الساحل إلى درعا وعفرين وجرمانا، وستقوم قريبا بزيارة محافظة السويداء، بهدف تقديم الدعم المادي والمعنوي.
وأكد رساس أن الرسالة الأساسية التي تسعى المبادرة إلى إيصالها هي “دم السوري على السوري حرام”، داعيا إلى رفض الفتن والتفرقة، وتعزيز الروح الوطنية الجامعة.
تقريب وجهات النظر
وقالت لين غريواتي، إحدى المشاركات في المبادرة من مدينة حلب، إن النقاش المفتوح يعد وسيلة مثلى لتسليط الضوء على المشكلات التي يواجهها السوريون اليوم.
وأوضحت للجزيرة نت أن مشاركتها في الفعالية جاءت دعما للطلاب الدروز الذين اضطروا إلى ترك جامعاتهم في حلب وحمص بسبب الأحداث الأخيرة، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى مثل تمكين المرأة، مؤكدة أن تغييب دورها في الماضي يجب ألا يتكرر مستقبلا.
بدوره، شدد مفيد كرباج، الناشط المدني من جرمانا، على أهمية كل مبادرة تسهم في تقريب وجهات النظر بين السوريين، وإعادة تعريف الانتماء إلى الهوية الوطنية الجامعة.
وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن الهدف النهائي يتمثل في بناء دولة مدنية تحترم الدستور وتمنح الحقوق لأصحابها دون تمييز، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات الداخلية.
المصدر : الجزيرة
—————————–
خط كركوك-بانياس.. هل يصل ما انقطع بين بغداد ودمشق؟/ دلشاد حسين
22 مايو 2025
رغم حالة الغموض التي تكتنف مسار العلاقات بين العراق وسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، يبرز بين حين وآخر حديث عن محاولات لفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين.
إحدى أهم الخطوات في هذا المجال المساعي لإحياء خط أنابيب النفط العراقي المار عبر سوريا.
وبدأت الحكومة العراقية رسميا، في أبريل الماضي، محادثات مع الجانب السوري لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط. وقد زار وفد عراقي رفيع المستوى دمشق لمناقشة خطط إعادة تأهيل الخط الذي ظل معطلا لعقود بسبب الحروب والإهمال.
وفي 25 أبريل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن وفدا حكوميا برئاسة حميد الشطري، رئيس جهاز المخابرات، وصل إلى دمشق بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين.
وذكر البيان أن المباحثات شملت قضايا متعددة من بينها مكافحة الإرهاب، تعزيز أمن الحدود، والأهم من ذلك، بحث إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الواصل بين كركوك وبانياس.
مصالح استراتيجية مشتركة
يقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، لقناة “الحرة” إن بغداد ودمشق تتشاركان الرغبة في استئناف تشغيل الخط، الأمر الذي سيعود بالنفع على البلدين وعلى لبنان أيضا.
“المناقشات بين الحكومتين مستمرة منذ فترة، وقد شهدت مؤخرا تقدما ملموسا على مستوى اللجان الفنية”.
ويضيف صالح أن التركيز الحالي منصب على الجوانب اللوجستية والفنية والقانونية، لا سيما إعادة تأهيل البنية التحتية وضمانات الأمان اللازمة لتشغيل الخط بشكل مستدام.
ويؤكد أن إعادة تشغيل الخط ستسهم في تسريع خطة العراق لتنويع مسارات تصدير النفط، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية:
“خط كركوك–بانياس يمنح العراق مرونة استراتيجية وتكلفة أقل، خاصة في ظل التحول الإقليمي نحو الاستقرار والتنمية المستدامة”.
ويشير صالح إلى أن هذا المشروع يمكن أن يعزز الاستثمار في قطاع النفط العراقي ويساعد البلاد على الوصول إلى هدف إنتاج 6 ملايين برميل يوميا، تماشيا مع الطلب العالمي المتزايد في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.
خلفية تاريخية
أُنشأ خط أنابيب العراق–سوريا عام 1934، بطول نحو 900 كيلومتر، ويمتد من حقول كركوك شمالي العراق مرورا بالأراضي السورية. وكان ينقسم إلى فرعين: أحدهما ينتهي في بانياس، والآخر في ميناء طرابلس في لبنان.
وقد شكل هذا الخط مسارا حيويا لتصدير النفط خلال القرن العشرين، حتى أوقفه النظام السوري عام 1982 أثناء الحرب العراقية–الإيرانية. ومنذ ذلك الحين، اعتمد العراق على مسارات أخرى مثل خط العراق–تركيا (ITP).
لكن أجزاء كبيرة من خط كركوك–بانياس تعرضت للدمار والسرقة، خاصة في المناطق السورية المتأثرة بالحرب، ولم يضخ العراق أي نفط عبر الأنبوب منذ أكثر من 40 عاما.
تحديات
يرى خبير الطاقة غوفيند شيرواني أن محاولات إحياء خط كركوك–بانياس مدفوعة حاليا باعتبارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية أو تقنية.
وفي حديثه لـ”الحرة”، يحدد شيرواني ثلاثة عوائق رئيسية:
أولها الأمن، إذ يمر الخط عبر مناطق لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية، حيث تنشط خلايا داعش وجماعات مسلحة أخرى”.
ويحذر شيرواني من أن ضمان الأمن الكامل على طول المسار شرط أساسي لأي تقدم.
العائق الثاني يتجسد في الحالة الفنية. ويشير خبير الطاقة إلى أن الخط الحالي “قديم، متآكل، وتعرض للتلف في عدة مناطق بشكل لا يمكن إصلاحه”. هناك حاجة لإنشاء خط جديد كليا أو تعديل المسار بناء على الوضع الميداني.
وأخيرة العائق المالي، فبناء خط جديد بطول 800 كيلومتر سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيتطلب ميزانية تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار، تشمل الأنابيب ومحطات الضخ ومراكز المراقبة والأمن.
خيارات بديلة
تزامنت عودة الاهتمام العراقي بالمسار السوري مع استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات الدولية لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا، والتي توقفت منذ أكثر من عامين بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات نفط الإقليم.
وأوضح شيرواني أن مقارنة خطي بانياس وجيهان التركي أمر طبيعي، لكنه أضاف: “خط جيهان جاهز من الناحية الفنية، والعوائق أمامه محدودة تقنيا وماليا، أما خط بانياس فهو مشروع جديد تماما ويتطلب دراسة جدوى اقتصادية كاملة”.
ومع ذلك، يرى شيرواني أن كلا المسارين مهمان ويتوافقان مع سياسة العراق الرامية إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على الممرات المهددة في منطقة الخليج، خاصة مع التوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإقليميين.
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا إلى “الحرة”، فإن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس قد تحقق عوائد مالية كبيرة لسوريا، من خلال خلق آلاف من فرص العمل، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، إضافة إلى دعم سوق الوقود المحلي عبر تكرير النفط العراقي بأسعار مخفضة في مصفاة بانياس.
العقبة الإيرانية
يؤكد المستشار الاقتصادي السوري، أسامة القاضي، أن المشروع اقتصادي في جوهره، لكنه معقد سياسيا وأمنيا، خاصة بسبب النفوذ الإيراني في العراق.
يقو القاضي إن المشكلة لا تتعلق بالبنية التحتية فقط، بل بوجود فصائل داخل العراق تعارض الحكومة السورية الجديدة، وتعتبرها دمشق أدوات إيرانية.
“طالما بقيت هذه الأطراف نشطة، لا أعتقد أن المشروع سيمضي قدما، حتى وإن تم توقيع الاتفاق”.
ويرى القاضي أن على بغداد اتخاذ موقف واضح ضد التدخلات الخارجية. ويلفت إلى أن التوترات الطائفية ما زالت تعيق التعاون الإقليمي.
تفاؤل حذر
رغم أن إعادة إحياء خط كركوك–بانياس يمثل فرصة استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية لكلا البلدين، لا تزال العقبات أمام تحقيقه كبيرة. ويعتمد التقدم في هذا المشروع على حلول هندسية واستثمارات مالية، إلى جانب تحسين الوضع الأمني وتسوية النزاعات السياسية العالقة.
في الوقت الراهن، يُعد المشروع اختبارا لإمكانية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وقدرة الدول الخارجة من النزاعات على التحول نحو تعاون مستدام.
دلشاد حسين
الحرة
—————————
“بركان الفرات” انفجار مسلح في وجه الروس بسوريا/ مصطفى رستم
فصيل هاجم قاعدة حميميم مخلفاً مقتل جنديين وحكومة الشرع تنفي صلتها بالعملية
السبت 24 مايو 2025
الهجوم على قاعدة حميميم الروسية من شأنه أن يطيح كثيراً من التفاهمات الدولية في حال تكراره بخاصة أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع تعمل على إجراء مفاوضات مع روسيا ودول غربية.
في تحد غير مسبوق للقوات الروسية العاملة في سوريا تبنى فصيل مسلح أطلق على نفسه “بركان الفرات” عملية الهجوم على قاعدة حميميم الروسية الواقعة في ريف اللاذقية غرب البلاد، ونتج منه مقتل جنديين روسيين وإصابة آخرين، أثناء المعركة، وسقط ثلاثة من المهاجمين من أصل أربعة بعد تغطية نارية قبل انسحابه وسط استخدام قذائف ومحاولة انتحارية لتفجير إحدى بوابات القاعدة الجوية.
وسارعت الحكومة السورية إلى نفي أي صلة تربطها بالهجوم وسط أنباء متضاربة عن الجهة التي أقدمت على الهجوم على قاعدة حميميم الواقعة جنوب شرقي اللاذقية، كبرى القواعد العسكرية في سوريا والمطلة على البحر المتوسط، وشكلت مركز عمليات منذ الحضور الروسي في الصراع السوري المسلح عام 2015 وخرجت منها الطائرات التي قصفت المدن والقرى التي خرجت عن سيطرة نظام بشار الأسد.
وحسم فصيل “بركان الفرات” المسلح الجدل بإقدامه على ضرب القاعدة، وأكد ذلك بيان صحافي متداول حمل اسمه، وتبنيه العملية قبل أيام. وحمل البيان في الوقت ذاته لهجة تهديد للقوات الروسية وأمهلها شهراً واحداً للخروج من البلاد قبل البدء في عمليات استهداف مباشرة. وقال البيان “الخروج من أرضنا، وإلا سنرسلكم إلى روسيا جثثاً هامدة من دون رؤوس”، مرفقاً اسم اثنين من المقاتلين اللذين سقطا هما جهاد المصري وأبو بكر الأنصاري.
إفشال التفاهمات الدولية
في غضون ذلك يسود التوتر أجواء القاعدة الجوية الروسية بعد الاستهداف الأخير، فعلى رغم الهجمات المتفرقة التي تعرضت لها القاعدة بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 فإنه الأخطر والأعنف، لا سيما أنها تأوي عائلات سورية من أبناء الطائفة العلوية قدمت بأعقاب أحداث الساحل في السادس من مارس (آذار) الماضي بعد هجمات من قبل فلول النظام السابق على دوريات للأمن العام في جبلة بريف اللاذقية أدت إلى إشعال فتنة وارتكاب انتهاكات فردية.
ومن موسكو، تحدث مدير مركز “جي أس أم” للأبحاث، الدكتور آصف ملحم، عن أن الغاية من هذا الهجوم إيصال رسالة إلى الكرملين بأن قواعده في سوريا مهددة، محذراً من استخدام ورقة الجماعات المسلحة المتطرفة دوماً حتى وإن كانت ربحت في إسقاط الأسد. وأضاف “منفذو الهجوم هم مجموعة من مقاتلين أجانب تحمل جنسية (الأوزبك)، ونعلم جيداً أن أعداداً كبيرة من المقاتلين وصلوا من جمهوريات آسيا الوسطى وتحديداً من ثلاث جمهوريات (طاجيكستان، أوزبكستان، كازخستان)، إضافة إلى مقاتلين قادمين من (الشيشان وداغستان) والشيشانيون والداغستانيون يحملون الجنسية الروسية وجميعهم عملياً محكومون من بلدانهم بتهم إرهاب، وغالب الظن أن الأحكام عليهم تتفاوت إما بالسجن المؤبد أو الإعدام، وخلال فترة انتشار ’داعش‘ في جمهوريات آسيا الوسطى حرم المقاتلون أن تنطق كلمة سوريا في الشارع”.
في الأثناء، يرى مراقبون أن مثل هذا التصرف والانفلات من شأنه أن يطيح كثيراً من التفاهمات الدولية في حال تكراره، بخاصة أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع تعمل على إجراء مفاوضات مع روسيا ودول غربية، وأثمرت الجهود العربية، خصوصاً السعودية، عن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وكان “بركان الفرات” أحد الفصائل المسلحة غير المنضبطة، أعلن قبل شهر عبر بيان له في الـ18 من أبريل (نيسان) الماضي عن تحذيره الحكومة الجديدة من مغبة احتجاز الأمن العام شخصية تسمى (أبو خولة) وأعطى مهلة 24 ساعة للإفراج عنه.
الفصائل والبحر
في المقابل يرى الباحث في شؤون السياسة السورية، محمد الهويدي، أن هذا الفصيل غير منضبط وأغلبه من أبناء دير الزور، مضيفاً “من وجهة نظري أن الفصيل وكثيراً من الفصائل غير المنضوية تحت جناح وزارة الدفاع، وتعمل بعقلية الميليشيات ستكون عبئاً على الدولة الجديدة، وبالتأكيد ستحارب الدولة لأنها تعمل بعقلية وبطريقة قتال وأيديولوجيا خاصة منها طرد الروس، وهذا عكس توجه الإدارة الجديدة”. وتابع “لا يمكن أن ننسى أن هذا الفصيل عارض الاتفاق الذي وقع بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكان لديه احتجاج ورفض ومثل هذه الفصائل ستدخل في صدام مع الإدارة الجديدة”.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن ما يسمى “سرايا بركان الفرات” أُسس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وانحصرت عملياته القتالية ضد القوات الروسية والإيرانية والقوات النظامية التابعة لبشار الأسد قبل هربه إلى موسكو، وتعمل باستقلالية تامة عن الفصائل الأخرى، وتبنت في وقت سابق عملية اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وهو أبو فاطمة العراقي.
كما تنتشر في شرق سوريا بمحافظات دير الزور وشاركت في عملية رد العدوان، وتمكنت من السيطرة على قرى في ريف دير الزور منها “العشارة” شرق المحافظة، وشاركت في عمليات بصورة مستقلة حتى محيط العاصمة دمشق.
ويذهب الدكتور ملحم بالحديث عن خطورة وصول هذه القوى المتطرفة إلى البحر لأنها ستتمكن من الوصول عبر شبكات التهريب إلى أوروبا، وهناك توافق عربي أميركي وإسرائيلي وروسي وصيني بعدم تمركز هؤلاء في سوريا، متوقعاً وقوع اقتتال بين الحكومة السورية والمقاتلين الأجانب الذين يصعب دمجهم في الجيش السوري الجديد، والهجوم حصل بعد الاجتماع الثلاثي في السعودية.
وقال ملحم “تمركز الجيش السوري معقد وصعب لمحاربتهم، وقد يكون المرشح معالجة هذا الملف روسيا وإسرائيل لامتلاك أسلحة عالية الدقة تستطيع إجراء عمليات عالية الدقة للتخلص منهم، وقد يتشكل تحالف لإجراء عملية عسكرية ليست واسعة النطاق لكن من الممكن أن تتدخل العراق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)”.
ورأى أنه من المرجح أن تتدخل قوات من الأردن ضمن تحالف غير واسع النطاق، ولن تستطيع القوات الأمنية للسلطات الجديدة التدخل، لأن الاشتباك معها سيدفع إلى انفجار اشتباكات في كثير من المناطق المختلفة في سوريا بين الجماعات التي تؤيد أحمد الشرع ومن معارضيه.
——————————–
من إرث تاريخي إلى صراع طائفي… لماذا ينقسم السوريون حول بني أميّة؟/ عائشة صبري
السبت 24 مايو 2025
تحوّل النقاش حول بني أميّة، في سوريا، من كونه جدلاً تاريخياً إلى أداة للصراع الطائفي والسياسي، خلال سنوات الثورة السورية، وبعد رحيل رأس النظام السابق بشار الأسد، وتولّي أحمد الشرع الرئاسة، حيث احتدم هذا الصراع حتى بات مؤيدو الرئيس الجديد يطلقون عليه لقب “قمر بني أميّة”.
المناكفات على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرّة بين السوريين المنقسمين بين من يدافع بشدّة عن إرث بني أميّة، ووسم دمشق بهذه الحقبة الزمنية، وبين من يرفض هذا التبنّي، ومن ينأى بنفسه عن هذا السجال المتواصل برغم تأكيد الشرع، خلال لقائه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي: “نحن أهل الشام مسالمون، ما علاقتنا بأحداث حصلت قبل 1400 سنة؟”، مستنكراً الخطاب الطائفي لإيران حول ثأرها للحسين بن علي بن أبي طالب.
ثم أتى مسلسل “معاوية”، ليثير الجدل خاصةً بسبب المغالطات التاريخية التي فيه، والذي عرضته قناة “MBC”، في رمضان 2025، ومنع العراق عرضه مثلما سبق ومنع عرضه بجانب فيلم “أبو لؤلؤة”، في موسم رمضان 2023، بسبب إثارتهما السجالات الطائفية.
وتأجج الصراع الإلكتروني، بعد تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، في 25 آب/ أغسطس 2024، حين أكد في حسابه على منصة إكس، أنَّ “المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية هي معركة مستمرّة، وتأخذ أشكالاً متعددة”.
إرهاصات الصراع
يقول الكاتب السياسي عمر الحاج حسن، لرصيف22، إنّ “اعتداد شريحة من السوريين بنسب بني أميّة، كان وما زال ردّة فعل على التصريحات الطائفية لمحور المقاومة، فمنذ عام 2011، أعلن زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله، في مقابلة مع الإعلامي غسان بن جدو، عن نيّة الحزب التدخل في سوريا، وفي أكثر من خطاب أكد نصر الله عباراته الطائفية، ومنها: ‘نخوض في سوريا حرباً وجوديةً’، حتى أنه قال لمقاتليه قبل الهجوم على القصير 2013: ‘ليتني رصاصكم’، بالإضافة إلى الشعارات الطائفية التي ردّدتها عناصر الميليشيات الإيرانية التي شاركت إلى جانب الأسد في قتال الجيش السوري الحرّ، وشماتة أنصار إيران بالضحايا السوريين والدعوات الطائفية إلى إبادتهم”.
هذا التدخل العسكري في سوريا كان تحت ذريعة دينية بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية في سوريا. هكذا بدأت الإرهاصات الأولى لما وصفه الحاج حسن بـ”تطييف الصراع”، لافتاً إلى أنّ “الثورة منذ انطلاقتها عام 2011، لم ترفع شعارات طائفيةً، بل كانت تحمل مطالب وطنيةً شاملةً، ولم يُذكر بنو أميّة، في خطاب الثوار، برغم أنّ السنّة يشكلون قرابة 80% من سكان سوريا”.
وفي المرحلة الثانية من الصراع بعد التدخل الروسي عام 2015، ارتفعت وتيرة التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية، خاصةً مع استعادة نظام الأسد، السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، ولا سيما بعد الجولة الأولى من مباحثات أستانا مطلع العام 2017.
في هذا السياق، تحوّلت ساحات رمزية، كصحن الجامع الأموي في دمشق، إلى أماكن تجمعات وطقوس لمنتمين إلى الطائفة الشيعية، وفي مطلع العام 2024، أثارت مشاهد ضرب الزوّار الشيعة قبر معاوية بن أبي سفيان، بالأحذية، موجة غضب، وتم تدمير الجامع الأموي في حلب، بالإضافة إلى نبش ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، في قرية دير شرقي جنوبي إدلب عام 2020، ما أحدث استنكاراً محلياً وعربياً حتى زعمت وزارة الأوقاف السورية حينها أنّ التخريب حصل من قبل “جبهة النصرة”. يقول الحاج حسن: “لم تكن هذه مجرد ردود عابرة، بل لحظات مفصلية عمّقت الشرخ الطائفي”.
يتابع: “إنّ إقامة طقوس اللطميات الشيعية في المحافظات السورية، خاصةً يوم عاشوراء، زادت من استفزاز سكان تلك المناطق السنّية”، لافتاً إلى أنّ هذه الأفعال كانت رسائل سياسيةً قبل أن تكون شعائر دينيةً، وتأتي في سياق مشروع متكامل بدأ مع دخول محور المقاومة إلى سوريا.
انقسام حول بني أميّة
يشير عمر الحاج حسن، إلى أنَّ السوريين توزّعوا في موقفهم من بني أميّة، على 4 تصنيفات:
1. كارهو بني أميّة سواء من أنصار “محور المقاومة” الذين يرون فيهم رموزاً معاديةً للشيعة، مستغلين القضية الفلسطينية كذريعة لمهاجمتهم، أو من العلمانيين كارهي الإسلاميين، وفي ذروة التراشق الإلكتروني، سادت تعبيرات ساخرة مثل “بني سمية” كسخرية من “أمية”، للإشارة إلى أنّ كلّ من يناصر الحكومة السورية الجديدة هو من أحفاد هذا “الإرث”.
2. الحياديون الذين يرون أنّ حقبة بني أميّة هي مجرد مرحلة من مراحل التاريخ لا تستحق هذا الجدل كله.
3. المعتدّون ببني أميّة نكايةً بالشيعة في وسائل التواصل الاجتماعي، لا عن فكر تاريخي، بل من نشوة انتصار سياسي مغلّف بالهوية الدينية، ومنها الردود الإنشادية بعد إصدار الشيعة أناشيد تسفّه بني أميّة، ومنها “صدى عزمك رج أميّة رج” للرادود خضر عباس، فردّ المنشد السوري ماجد الخالدي، بأنشودة بلحن مماثل باسم “بنو أمية أصلهم ذهب”، وتوالت الردود بين الطرفين، وكانت آخرها “رجع جيش أميّة”.
4. بعض المثقفين الذين يعتدّون بالإرث الأموي، مثل المذيع معاذ محارب، والناشط السياسي طارق البابا.
ويقول البابا، لرصيف22: “الحضارة الأموية تُعدّ جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والتاريخية لدمشق وسوريا عموماً، وأيّ محاولة لفصل بني أميّة عن التاريخ السوري هي بمثابة نزع ثوب حضاري متجذر في عمق المنطقة”.
يضيف: “الحضارة الأموية التي انطلقت من دمشق، تفتخر بها اليوم دول كبرى مثل إسبانيا (الأندلس)، فكيف لا نكون نحن أولى بهذا الفخر؟ خلال زيارتي إلى إسبانيا، لمست محبّة الناس وتقديرهم لنا، وقد استُقبلتُ في غرناطة وكأنّني أحد أحفاد طارق بن زياد. لا أنسى ما قاله لي صاحب الفندق عندما وصلت: ’ضع أغراضك واستمتع بحضارة أجدادك‘. كلمات تعبّر عن حجم التقدير لهذه الحضارة العربية والإسلامية”.
ويلفت البابا، إلى أنّ الإرث الأموي لا يزال حاضراً في تفاصيل الحياة الأندلسية حتى اليوم، سواء من خلال النقوش المستوحاة من فنون دمشق التي تزيّن جدران قصر الحمراء، أو من خلال الأشجار المثمرة التي نُقلت من بلاد الشام واستقرّت في الأندلس منذ ذلك الحين.
كما يشير أيضاً إلى أنّ “العديد من المدن الأندلسية لا تزال تحمل أسماء ذات أصول أموية، مثل غرناطة، قرطبة، إشبيلية، طليطلة، الجزيرة الخضراء، مضيفاً أنّ بلدة ‘الهامة’ في ريف دمشق التي ينحدر منها، توجد بلدة تحمل اسمها نفسه في إسبانيا، لذلك، فإنّ إعادة إظهار هذا الإرث للعالم ليست ترفاً، بل مسؤولية. أمّا النقاشات التي تُثار حول هذا الموضوع، فأعدّها غير مجدية، لأنّها بالنسبة لي أمر واقع لا جدال فيه”.
ومن الحياديين في ما يخصّ بني أميّة، المفكر والكاتب السوري وائل الشيخ أمين، الذي يقول لرصيف22، إنّ “كلّ أمّة لها جذور حضارية من حقّها أن تفتخر بها، وهذا يزيد من عزّتها وثقتها بنفسها، والتاريخ يستفاد منه في الفترات الحرجة ليكون عوناً على النهوض”.
لكن لا يعتقد الشيخ أمين، أنّ التغنّي ببني أميّة هو الاستدعاء المناسب للتاريخ الذي نحتاجه اليوم، عازياً السبب إلى أنّه يزيد الشرخ بين المكونات السورية، فلو سألنا الشيعة والعلويين عن ألدّ أعدائهم التاريخيين لما اختاروا سوى بني أميّة، بل إنّ الكثير ممّن يتغنّون ببني أميّة يكون تغنّيهم من باب المناكفة ورد الفعل، لا غير.
ويخشى الشيخ أمين، من أنّ يتسبب حصر التغنّي ببني أمية والمبالغة فيه، في “انتكاسة في بعض القيم التي ثُرنا من أجلها”، حيث يدفع بعض السوريين إلى الدفاع عن مسألة توريث الحكم، برغم أنّ الثورة السورية قامت ضد حكم عائلة الأسد، كما برّر آخرون ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، واستبداده، والثورة قامت ضد الاستبداد والظلم.
هوية غير دينية
يوضح الباحث السوري طالب الدغيم، الحائز على دكتوراه في التاريخ، في حديثه إلى رصيف22، “أنَّ العهد الأموي حوّل دمشق من مدينة إقليمية إلى عاصمة خلافة إسلامية خارج الجزيرة العربية، بعد أن كانت المدينة المنوّرة مركز الدولة ثم الكوفة في عهد علي بن أبي طالب وابنه الحسن الذي تنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان، وكانت دمشق مركز القرار في دولة امتدت حدودها من الصين شرقاً إلى الأندلس (إسبانيا) غرباً.
ولهذا، بحسب الدغيم، فإنّ “الهوية الأموية ليست دينيةً أو مذهبيةً، بل تمثّل ذروة النفوذ العربي والإسلامي من قلب الشام، وارتبطت بفترة ازدهار إداري وحضاري كبير، وهذا التميّز التاريخي، يجعل معظم السوريين، خصوصاً بعد ثورة 2011، يرون في دمشق الأموية نموذجاً مضاداً لحكم الانفصاليين والأسديين وأتباع المحور الإيراني”.
من جانبه، يقول الدكتور في التاريخ الإسلامي حسام الدين الحزوري، لرصيف22، إنَّ “إعلان دمشق عاصمةً لبني أميّة كان تحوُّلاً جذرياً إذ أصبحت عاصمة العلم والعمران والاقتصاد والسياسة ومركز الفتوحات الإسلامية، وحاضرة العالم حيث تستقطب الجميع، ومع توسّع الدولة وتدفق الغنائم، خاصةً في عهد الوليد بن عبد الملك، شهدت الدولة الأموية نهضةً بمختلف جوانب الحياة خاصةً التطوير العلمي، ولُقّب ذاك العصر بالعصر الذهبي”.
وبحسب الحزوري، “ما يميّز الدولة أنّها عربية كليّاً، فجميع رجالها كانوا من العرب ولم يتزوّجوا من أجنبيات كما خلال الدولة العباسية، كما ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ببني أميّة وطُبعت بطابع خاص، ولم يعرف الدمشقيون دولةً رسمت وجودها مثلها، حيث أعطيت اللغة العربية مكانتها بين اللغات حينذاك، ودُوّنت الدواوين وعُرِّبَت بعد أن كانت تُكتب باللغتين الفارسية والبيزنطية، كما عُرّبت العملة النقدية بعد أن كانت بيزنطيةً، وأصبحت للدمشقيين مدرسة خاصة قائمة على معالم الحضارة الإسلامية الجديدة، ومن أبرز معالمها بناء المسجد الأموي، أحد رموز العمارة الإسلامية المبكرة”.
ويشير إلى “عام 41 للهجرة 661م، تاريخ إقامة الدولة الأموية الذي عُرف بـ’عام الجماعة’ لتوحيد المسلمين تحت حكم واحد بعد انقسام في ما بينهم (قسم مع علي، وقسم مع معاوية)، باستثناء طائفة واحدة لم تبايعه هي الخوارج، وبذلك تم تأسيس الدولة الأموية ورفعت الأعلام البيضاء وأصبح معاوية أول خليفة أموي للأمة الإسلامية بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين الأربعة”.
إلى ذلك، أنشأ الأمويون منطقة الثغور التي تفصل بينها وبين الدولة البيزنطية، وهي حالياً المدن التركية الجنوبية، كما يقول الحزوري، وتم الانتقال من الشورى إلى الملك العضوض والحكم الوراثي، والانتقال من الدولة الفكرة إلى الدولة القوية الجامعة التي تفرض سطوتها على مكوناتها المختلفة.
ويذكر أنّ اعتزاز السوريين بالدولة الأموية، يعود إلى أيام مجدهم وعزّهم خلال تلك الحقبة الزمنية، خاصةً أنَّ الدولة العباسية عاملت أهل الشام بنوع من الإذلال والإهانة، فكانوا أمويّي الهوا والانتماء وعانوا عقب سقوط دولتهم، ووصف أحد المؤرخين سقوط دمشق في 14 رمضان 132هـ على يد العباسيين، كـ”أفظع مأساة في التاريخ الإسلامي”، وانتقل مجد دمشق إلى الكوفة، وهذا معنى ارتباط دمشق ببني أميّة.
وبعد رحيل بشار الأسد، والمعاناة التي خلّفها نظام البعث لأكثر من 60 عاماً، استذكر بعض السوريين لقب “قمر بني هاشم”، الذي أُطلق على العباس بن علي بن أبي طالب، لشدّة جماله، فاقتبسوا منه لقب “قمر بني أميّة” المستحدث للرئيس أحمد الشرع.
حقيقة الخلاف السنّي الشيعي
إنَّ الرواية التاريخية حول شخصيتَي معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، هي أحد جذور الانقسام السنّي-الشيعي، إذ تتجاوز الخلاف السياسي لتتحوَّل إلى رمزيات عقدية، كما يقول طالب الدغيم، مستنداً إلى الرؤية السنّية التي يُنظر فيها إلى معاوية بوصفه صحابياً كاتباً للوحي، وأميراً محنّكاً أسّس دولةً قويةً بعد فترة الفتن، كما أنّ ابنه يزيد يُعدّ في منظورهم خليفةً أخطأ دون أن يُكفَّر، ويُفصل بين فعله وبين شرعية الدولة.
في المقابل، ترى الرواية الشيعية أنّ معاوية انقلب على الإمام علي بن أبي طالب، وأنّ ابنه “يزيد” مسؤول بشكل مباشر عن استشهاد الحسين بن علي، في كربلاء، وهو رمز الدولة العباسية التي اتخذت من اللون الأسود رمزاً لها وعلماً، يضيف الدغيم، ما يجعل بني أميّة رمزاً للظلم والانحراف عن مسار الإمامة الشرعية، حسب هذه الرواية، وهذا سبب كره الشيعة لبني أميّة.
هذا التناقض العميق جعل من المرحلة الأموية مادة خلاف تتكرّر في كلّ صراع مذهبي، حيث يُعاد استحضار هذه الرموز إمَّا لتثبيت السردية السنّية عن “الدولة والشرعية”، أو لتأكيد السردية الشيعية عن “المظلومية والانحراف”، وفقاً للدغيم.
هل يمكن أن يكون الإرث الأموي مشروعاً وطنياً جامعاً؟
من الناحية المبدئية، يرى طالب الدغيم، أنّ الإرث الأموي يمكن أن يُعاد تقديمه كجزء من مشروع وطني جامع للسوريين، بشرط إعادة قراءته كمرحلة سياسية وإدارية متقدّمة، لافتاً إلى أنّ نجاح هذا المسعى يتطلّب تجاوز التوظيف الطائفي أو الانتقامي، وتقديم التجربة باعتبارها نموذجاً لبناء الدولة والإدارة، وتوسيع الهوية الجامعة لكل السوريين.
يضيف: “المصالحة مع الإرث الأموي تتطلّب فصل التاريخ عن الأدلجة، والهوية الوطنية التي تواجه نظام الأسد البائد عن العقائد، وتقديم سردية تاريخية متّزنة تعترف بالتنوع والمواطنة العادلة، وتتفهم أسباب الجدل التاريخي والصراع المذهبي وخلفياته السياسية والقومية، بما يجعل هذا الإرث الأموي رصيداً وطنياً لا نقاط خلاف”.
رصيف 22
—————————————
التهريب وتصاعد نشاط «الدولة»: التحدي الأمني يهدد استقرار سوريا/ منهل باريش
يثير تنامي نشاط تنظيم «الدولة» قلقًا متزايدًا، حيث أظهر التنظيم قدرة على الانتقال من البادية السورية إلى الحواضر المدنية، وساهم ضعف الأجهزة الأمنية في تسهيل هذا التحول.
قُتل عنصران من الجيش السوري على يد الحرس الروسي في قاعدة حميميم العسكرية بعد هجومهما على القاعدة. ووفقًا لمصدر أمني سوري، نقلت القوات الروسية جثتي القتيلين إلى داخل المطار العسكري، الذي يُعدّ مقرًا لقيادة القوات الروسية العاملة في سوريا. ورفضت القوات الروسية تسليم الجثتين إلى جهاز الأمن العام حتى مساء الجمعة.
وكشفت صحيفة «القدس العربي» هوية أحد المهاجمين، وهو الشاب عمار مصطفى الحسن «الحركوش»، المنحدر من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي. يُشار إليه أيضًا بلقبَي «أبو بكر الأنصاري» أو «أبو بكر السفراني». وعلى عكس ما أوردته بعض الوكالات الإخبارية، فإن القتيل كان عنصرا عاديا في الجيش السوري، وليس مدربا في الكلية البحرية على الساحل السوري. كما تبين أنه كان منضمًا سابقًا إلى حركة «أحرار الشام» الإسلامية، قبل أن ينضم إلى الجناح العسكري لهيئة «تحرير الشام» قبيل معركة «ردع العدوان».
وعلمت «القدس العربي» بأن ثلاثة مهاجمين، بينهم مقاتل مصري الجنسية، تسللوا عبر حواجز الأمن العام في المنطقة، واستهدفوا أحد مهاجع الحرس الروسي على أطراف المطار. ردت القوات الروسية على مصادر النيران، فقتلت إثنين من المهاجمين، بينما لا يزال مصير الثالث مجهولًا. وخوفًا من هجوم أوسع، استنفرت القوات الروسية قواتها، ووضعت مقاتلاتها الجوية في حالة تأهب قصوى، مع تشويش إلكتروني على الترددات اللاسلكية لقطع الاتصال بين المهاجمين ومنع استخدام طائرات مسيرة في هجوم محتمل.
مؤشرات مقلقة لنشاط تنظيم «الدولة»
على الصعيد الأمني، أعربت إدارة الأمن العام عن قلقها من نشاط محتمل لتنظيم «الدولة» في عدة مناطق، مركزة تحذيراتها على أقسامها في محافظة حلب، خاصة مدينتي الباب وأعزاز.
وأشار تحذير الأمن العام إلى أن خلايا التنظيم تعمل على «رصد مواقع عسكرية وأمنية تابعة للجيش السوري وإدارة الأمن العام، بهدف تنفيذ عمليات نوعية». ودعت الإدارة جميع العناصر العسكرية والأمنية، بما في ذلك الاحتياط، إلى «رفع الجاهزية الأمنية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتكثيف عمليات الرصد والتفتيش، خاصة في محيط المواقع العسكرية والمقرات». كما شددت على ضرورة مراقبة محلات بيع الأسلحة، ومنع تداولها بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المدنيين الذين يحملون أو يشهرون السلاح، وذلك حفاظًا على الأرواح والاستقرار.
في سياق متصل، شهدت مدينة حلب، الثلاثاء، أول اشتباك مباشر في قلب المدن السورية بين جهاز الأمن العام وخلايا تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية». جاء ذلك خلال حملة أمنية لملاحقة خلايا التنظيم، حيث داهمت قوة خاصة من جهاز الأمن العام، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، خليتين تابعتين للتنظيم في حيي الحيدرية والجزماتي بمدينة حلب.
وواجهت عملية الدهم مقاومة من عناصر الخلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عنصر من قوات الأمن العام وإصابة ثلاثة آخرين في حي الجزماتي، أحد الأحياء الشرقية للمدينة. وخلال العملية، فجر أحد عناصر التنظيم نفسه أثناء الاقتحام. وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال ثلاثة أشخاص سوريي الجنسية، لم يكن بينهم أي أجنبي، وتم تحديد هوياتهم، وهم: إبراهيم القاسم، الملقب «أبو إسراء»، من دير حافر بريف حلب الشرقي؛ ومحمد المصطفى، الملقب «أبو حميد»، من طعانة أخترين بريف حلب الشمالي؛ وأسامة الحمد، الملقب «أبو عبد الرحمن»، من دير الزور.
وواصلت دوريات الأمن ملاحقة عناصر مشتبه بهم، وفتشت منازل مجاورة وأخرى يُشتبه بأنها تأوي عناصر إضافيين من التنظيم.
في إدلب، يُعتبر جهاز الأمن العام الأكثر فعالية وسرعة استجابة مقارنة بالمناطق السورية الأخرى، بفضل بنيته التنظيمية القوية وعلاقاته المحلية المتينة. هذه العوامل ساهمت في تقليص الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك عمليات السطو والجريمة المنظمة، بشكل ملحوظ مقارنة بمدن مركزية مثل دمشق وحلب، أو مناطق الساحل ذات الغالبية العلوية.
في هذا السياق، يُفسر التحرك السريع للقوات الأمنية في إدلب بنجاحها في التصدي لعدة حوادث، أبرزها مقتل عنصر من وزارة الدفاع في كمين نصبه تنظيم «الدولة» بمنطقة مدايا بريف خان شيخون الشرقي، استهدف عنصرا في وزارة الدفاع. كما تعرضت وحدات من الجيش الجديد لكمين سابق في منطقة قريبة شمال خان شيخون، على الطريق بين بلدتي معرة حرمة والشيخ مصطفى، أسفر عن مقتل عنصرين عسكريين. هذه الحادثة دفعت جهاز الأمن العام إلى تكثيف جهوده لتعقب خلايا مشتبه بانتمائها إلى تنظيم «الدولة».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق من هذا العام، إحباط محاولة تفجير كبيرة قرب مقام السيدة زينب جنوبي دمشق. وتزامن ذلك مع مخاوف من هجوم واسع النطاق للتنظيم على دمشق خلال عيد الفطر، حيث حذرت بعثات دبلوماسية غربية رعاياها من هجمات محتملة تستهدف الأسواق، المطاعم، والمساجد خلال صلاة العيد.
شبكات موالية لإيران في مرمى الأمن العام
في سياق متصل، تواصل الخلايا الأمنية الموالية لإيران في شرق سوريا محاولات نقل السلاح باتجاه لبنان بدون توقف، وتسعى إدارة حرس الحدود لإحباط مختلف العمليات سواء تلك القادمة عبر الحدود أو المخزنة في مستودعات سرية في شرق سوريا ومناطق التهريب النشط في تل كلخ والقصير والقلمون وريف دمشق الغربي.
وأعلن جهاز الأمن العام في البوكمال عن ضبط شحنتي أسلحة، إحداهما قادمة من العراق إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والأخرى متجهة إلى الساحل السوري. وقال مدير أمن البوكمال إن قواته تعمل على «تأمين الحدود السورية-العراقية الطويلة والمعقدة»، مشيرًا إلى وجود قنوات تنسيق مع الجانب العراقي، لكنها «تعاني تأخيرًا بسبب الظروف السياسية».
وفي سياق جهود مكافحة التهريب، هاجم جهاز الأمن العام شبكة تهريب أسلحة ومخدرات يقودها حسين العلي الجغيفي، الملقب بـ«الحوت»، والمعروف بتبعيته لإيران في البوكمال. ونشرت إدارة الأمن العام تسجيلات مصورة تظهر اعتقال العلي وعددا من أبنائه وأفراد شبكته. وكشف مدير أمن البوكمال، مصطفى العلي، الأربعاء، عن العثور على 70 ألف حبة كبتاغون في منزل الجغيفي ببلدة الهري الحدودية، مؤكدًا استمرار عمليات البحث عن مستودعات أسلحة ومخدرات مخفية في المنطقة. كما نشرت الإدارة صورًا لصواريخ إيرانية مضادة للدروع، وصواريخ روسية المنشأ، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة.
وتُعدّ الحدود السورية-اللبنانية، خاصة في منطقة عكار اللبنانية وتلكلخ السورية، من أخطر مناطق التهريب وأصعبها بسبب التداخل الجغرافي. حيث يعيق نهر الكبير الجنوبي، الذي يفصل الحدود، جهود الضبط الأمني، بينما تزيد الجغرافيا الجبلية في القلمون الغربي من تعقيد العمليات، بسبب امتداد سلسلة جبال لبنان الشرقية على طول الحدود من القصير إلى جبل الشيخ، ما يجعلها ممرًا تاريخيًا للتهريب بين البلدين.
ووفقًا لإحصاءات جهاز الأمن العام، يتم إحباط عملية تهريب كل يومين تقريبًا، ما يشير إلى حجم العمليات الناجحة التي يتمكن المهربون من خلالها من نقل الأسلحة إلى لبنان أو تهريب حبوب الكبتاغون إلى الداخل السوري. وخلال الأيام الأخيرة، كشفت القوات الأمنية ووزارة الدفاع عن إحباط شحنة أسلحة مضادة للدبابات، وأكثر من 100 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» المتفجرة. وأظهرت صور متداولة مستودعًا لتجميع الأسلحة يحتوي على صواريخ إيرانية الصنع من طراز 107 ملم مع قاذفاتها.
وفي منتصف الشهر الجاري، اعترضت عناصر الأمن العام وفرقة حمص شحنة صواريخ أرض-أرض من نوع «غراد» المطورة (عيار 220 ملم)، وفقًا لتحليل الصور التي اطلعت عليها «القدس العربي». وفي القلمون الغربي، ضبطت القوات الحكومية السورية شحنة أسلحة وذخائر متجهة إلى لبنان عبر منطقة سرغايا، وأكدت مصادر في إدارة حرس الحدود اعتقال مهربين إثنين مع مصادرة شاحنتهم. وقبل هذه الحادثة، أحبط حرس الحدود عملية تهريب صواريخ «كورنيت» المضادة للدروع وقاذفة قنابل يدوية إيرانية الصنع.
تكشف الأحداث الأخيرة أن التحدي الأمني بات الهمّ الأبرز في سوريا بعد تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ويثير تنامي نشاط تنظيم «الدولة» قلقًا متزايدًا، حيث أظهر التنظيم قدرة على الانتقال من البادية السورية إلى الحواضر المدنية. وقد ساهم ضعف الأجهزة الأمنية في عدة مناطق، خاصة تلك التي كانت خارج سيطرة المعارضة قبل سقوط النظام، في تسهيل هذا التحول. ويبرز هذا الضعف بوضوح في الفجوات الأمنية التي سمحت للتنظيم بإعادة تنظيم خلاياه في المدن.
في الوقت ذاته، تظل مشكلة تهريب الأسلحة ونشاط الخلايا الموالية لإيران، مع احتمال اختراقها للأجهزة الأمنية السورية الجديدة، من أبرز العوائق التي تعرقل تحقيق الاستقرار. وتتركز هذه التحديات في المناطق الحدودية، سواء في غرب سوريا أو شرقها، حيث تستمر محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود مع لبنان والعراق، ما يهدد الأمن الإقليمي ويعقّد جهود إعادة بناء الدولة.
———————————
مما ينبغي قوله حين ينبغي أن يقال/ نبيل الملحم
24 مايو، 2025
وقد انتصر الإسلاميون، يأتي السؤال:
ـ هل ننظر إلى انتصارهم بعين النعامة، أم بلغة الببغاوات؟
في قلب سؤالنا هذا يكمن جرحٌ سوري عميق، ليس فقط جرح الاستبداد الذي جثم على صدر البلاد لعقود، بل أيضًا جرح المعارضات الديمقراطية (والتسمية هنا مجازفة) التي لم تفلح – في كثير من مراحلها – أن تكون البديل أو الأفق أو الحلم.
وحين نتساءل: لماذا مال قطاع واسع من الجمهور إلى الإسلاميين، علينا أولًا أن ننزع النظارة الأيديولوجية التي تحجب عنا رؤية الواقع كما هو، لا كما نشتهيه.
ـ انتصروا؟
أي نعم، وعلينا أن نخلع من عقولنا لغة الإنكار، أما كيف؟ ولماذا؟ فهما السؤال، مواجهته تعني “شجاعة”، والهروب منه كما تستحم بالوحل لغسل الوحل عنك.. ولمواجهته كل ماعلينا أن نأخذ علماً بأنه :
لم تكن المشكلة في “لغة” المعارضات الديمقراطية والعلمانية فقط، بل في “البنية الذهنية” التي حملتها، وما حملته، رغم شجاعتها وتاريخ بعض رموزها النضالي، قد أسقطها في فخّ استنساخ أدوات خصمها:
ـ بالشعارات الطافحة بالمفردات الجوفاء: “تحقيق العدالة الاجتماعية”، “بناء دولة المواطنة”، دون أن تقدّم برامج ملموسة توضح آليات ذلك.
ـ في “عقدة الزعيم”، وفي المنازعات الصبيانية على “القيادة”، بدل أن تصوغ عقدًا جامعًا.
ـ في فساد ورثته من سلطة فاسدة، فأعادت إنتاجه حين سنحت لها الفرصة في الفساد.
ـ في خيبة تواصلها الحقيقي مع الطبقات الفقيرة أو الريفية، وفي خطابها النخبوي ، وهو يدور في صالونات برلين أو واشنطن وباريس، ولا يُترجم إلى فعل ميداني.
ـ في عجزها عن ابتكار أدوات كفاحية، في التنظيم والرسالة والتواصل.
ـ في عجزها عن انتاج رموز ملهمة قادرة على تحريك الناس، كما فعل الإسلاميون في قراهم ومساجدهم.
واستعادة للسؤال:
ـ هل هذا حال الإسلاميين؟
لدى الإسلاميين – خصوصًا التيارات الإخوانية والسلفية – كانت هناك “ثروة” تنظيمية وروحية لا يمكن إنكارها.
كان لهم:
ـ إرثاً طويلاً من العمل السرّي والتنظيمي، ما جعلهم مهيئين لقيادة العمل تحت سطوة القمع والتكيل.
ـ وكان لهم خطاباً بسيطاً، مفهوماً، ومرتبطاً بالمقدس، جعل منه مادة سهلة التداول لدى الجمهور.
وكان لهم شبكات إغاثية وتعليمية وصحية لعبت دورًا محوريًا في كسب الحاضنة الشعبية، خاصة في الفضاءات المهمّشة.
كما كان لهم قدرتهم على خلق انضباط داخلي، وعلى تقديم نموذج للقيادة (حتى وإن كان استبداديًا بدوره)، بدا اكثر التصاقاً بالناس من خطاب معارضات مبعثرة ومتشرذمة.
هل نلوم الجمهور؟
أن نُحمّل جمهورًا مسحوقًا ومُهانًا ومقموعًا لعقود مسؤولية خياره في لحظة ارتباك تاريخية، لهو ضربٌ من الإنكار.. الجمهور، بطبيعته، يبحث عمّن يفهمه، يطمئنه، يقوده، ويمنحه إجابة على أسئلته الوجودية. وعندما فشلت المعارضة العلمانية واليسارية في لعب هذا الدور، لم يكن غريبًا أن يتقدّم الإسلاميون، خصوصًا في لحظة الفوضى والانهيار.
ومن ثم ألا ينبغي أن نطرح السؤال بشكل مغاير:
ـ هل كانت الخيارات الأخرى واضحة أو مطروحة أصلاً أمام هذا الجمهور؟
ـ أم أننا نحاكمه بأثر رجعي على مسارات لم تكن مفتوحة أمامه؟
المطلوب ليس جلد الجمهور، بل الاستثمار في المرايا، عبر نقد صارم من القوى التي ادعت تمثيله، دون أن تمتلك ما يؤهلها للتمثيل.. نقد صارم لنفسها كما يفعل (دكنجي) بضاعته كاسدة هو بلا وجه بشوش.
أما عن الجمهور، فالجمهور السوري – ككل جمهور – لا يُلام لأنه اختار من قدّم له شيئًا، بل يُفهم، ومعه يبقى السؤال:
ـ ماذا يعني أن تكون معارضاً حقيقياً، لا ظلًا باهتًا لسلطة فاسدة سقطت وأسقطتك:
ـ أسقطتك يوم اتخذت دلالتك من الخصومة لامن تماسك المشروع.
——————————
العودة إلى سوريا ليست نهاية الطريق.. السكن والتعليم والصحة اختبار قاس للعائدين/ مختار الإبراهيم
2025.05.25
العودة إلى سوريا ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة محفوفة بالتحديات. بعد أكثر من أربعة عشر عامًا من الحرب، يعود أكثر من 1.5 مليون سوري إلى بلادهم ليكتشفوا واقعًا يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. في ظل غياب التنظيم القانوني لسوق الإيجارات، وارتفاع أسعار السكن، وتراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، يجد العائدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع هشاشة يومية تعمق الإحساس بالغربة داخل الوطن. وبين تفاوت في توفر الخدمات من مدينة لأخرى، واستمرار الانهيار الاقتصادي، يصبح قرار العودة بحد ذاته مغامرة شخصية لا تضمن الاستقرار، بل تطرح أسئلة جديدة عن القدرة على الاستمرار.
أعلنت الأمم المتحدة عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم منذ سقوط نظام الأسد، وقالت أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “يحتاج 16.5 مليون شخص في سوريا للمساعدات الإنسانية والحماية”، مؤكدة استمرار العمليات الإنسانية رغم الصعوبات المتزايدة، وأضافت: ‘تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ما متوسطه 2.4 مليون شخص شهريًا من خلال عملياتها المحلية والعابرة للحدود.
وبعد أكثر من أربعة عشر عامًا من الحرب، لم تعد سوريا كما كانت. أدى النزاع إلى انهيار اقتصادي وخدمي واسع، مع نسب فقر تتجاوز 90% من السكان وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وبطالة متفشية، وتراجع في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة. رغم محاولات التعافي، فإن الواقع على الأرض لا يزال قاسيًا، وهو ما اكتشفه السوريون العائدون إلى بلادهم بعد سنوات في الخارج.
غلاء في الإيجارات وتراجع للخدمات
في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، عبّرت إسراء، إحدى السوريات العائدات من الخارج، عن تردي الواقع الخدمي والمعيشي، “أول مشكلة واجهتنا كانت الإيجارات، المبالغ المطلوبة كبيرة جدًا، ولا يوجد أي قانون ناظم لهذا الموضوع… صاحب المنزل يطلب السعر الذي يراه مناسبا دون ضوابط.”
كما أشارت إسراء إلى موضوع غلاء المواصلات داخل المدن، وارتفاع أسعار الفنادق، حتى أن قضاء يوم واحد في دمشق يشكل عبئًا ماليًا لشخص يحاول أن يسافر إلى دمشق للتقدم إلى وظيفة على سبيل المثال. أما الكهرباء، فشهدت تحسنًا طفيفًا في العاصمة، في حين لا تزال المدن الأخرى مثل مصياف -حيث تقيم إسراء- تعاني من انقطاعات طويلة، بوصل لا يتعدى نصف ساعة كل خمس إلى ست ساعات، يضاف إليها موضوع المياه أيضًا تصل مرة كل خمسة أيام ولساعات قليلة.
وتصف إسراء الشوارع “بالموحشة” نتيجة للظلام الدامس، ما جعل مدينة مصياف مثلا تبدو كمدينة أشباح، رغم وجود مبادرات محلية محدودة لتحسين الإنارة، لكنها تبقى غير كافية. وفيما يخص الغلاء، ترى إسراء أن أسعار السلع الغذائية انخفضت قليلاً، لكن هناك مصاريف كثيرة ترهق كاهل السوريين مثلا التعليم الحكومي لا يزال ضعيفًا، ويعتمد الطلاب على الدروس الخصوصية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية وهي مكلفة للغاية.
أين يسكن العائدون في دمشق؟
لكن مشكلة تأمين السكن تلقي بظلالها على من يفكر السكن في دمشق، وهنا يقول موسى بركات إنه بحث لأشهر عن منزل للإيجار، ووجد واحدًا فقط في ضواحي دمشق بأكثر من 200 دولار شهريًا، وذلك نتيجة لتدمير واسع في البنية السكنية في عموم سوريا، وغياب العرض الكافي للعائدين.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن حوالي 26.3% من الوحدات السكنية في سوريا تعرضت للدمار أو لأضرار جسيمة، وتم تدمير أكثر من 150 ألف وحدة في حلب وحدها. أما في دمشق، فقد فقدت المحافظة نحو 57 ألف وحدة سكنية، هذا النقص الحاد أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 300% في بعض المناطق.
من جهتها تؤكد بتول ما قاله موسى عن صعوبة الحصول على سكن للإيجار رغم الأرقام الفلكية مقارنة بالدخل، وتؤكد أن عودتهم من تركيا لم تكن إلى منزلهم الأصلي، فالقابون حيث كانوا يقطنون قبل الثورة وبلدة الصرخة في القلمون -بلدة أهل زوجها- دمرتا بالكامل، ما دفعها للاستقرار في حرستا، بالقرب من سكن أهلها، مع دفع إيجار شهري. وفي حديثها عن الوضوع الأمني تصف بتول الوضع الأمني بالمقبول، إلا أن “أخبار الحوادث الأمنية المتفرقة تنعكس سلبا على الجميع”.
التعليم والرعاية الصحية في سوريا
وعن التعليم، اضطرت بتول لتسجيل ابنها بمدرسة خاصة لرفض المدرسة الحكومية تسجيله لأن العام الدراسي اقترب على نهايته، وتصف مستوى التعليم الخاص بأنه “جيد وقريب من مستوى المدارس الحكومية في تركيا”.
كما تشير بتول إلى أن الرعاية الصحية مقبولة في مشفى حرستا، وخدمات المشفى الوطني جيدة. لكن الأدوية الأجنبية مرتفعة السعر وتدخل تهريبًا، كما لاحظت وجود فرق كبير بالخدمات بين حرستا ودمشق، حتى في جودة الهواء نتيجة للغبار والدمار.
أما بما يخص الاتصالات فقد تحسنت خدمة الإنترنت، فقد أصبح الإنترنت الفضائي متاحًا بعد أن كان محصورًا على الهاتف الأرضي، وكذلك المياه تحسّنت في منطقتها.
رغم التفاؤل الذي يحمله بعض العائدين، فإن الواقع السوري بعد أكثر من عقد من الحرب لا يزال يفرض تحديات ضخمة. من الإيجارات غير المنظمة، إلى الخدمات المتفاوتة، مرورًا بالدمار العمراني الذي حوّل العودة إلى اختبار قاسٍ للقدرة على التحمّل.
تعد شهادات بتول وإسراء وموسى جزءًا من مشهد أكبر، يُظهر الحاجة المُلحّة لإصلاحات واقعية، تبدأ بوضع حد لفوضى السكن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار للأسر التي اختارت العودة.
العودة إلى سوريا ليست قرارا سهلًا، ولكن من دون استجابة حقيقية من الجهات الرسمية، قد تصبح مجرّد رحلة جديدة في درب المعاناة.
ولعل التفاؤل بأن ينعكس رفع العقوبات الأميركية إيجابا على الاقتصاد والشروع بإعادة الإعمار هو ما يجمع كل من التقاهم موقع تلفزيون سوريا، فقد أعلن مؤخرا الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال فترات زمنية مختلفة.
تلفزيون سوريا
————————————-
نظام طهران يترنح.. أزمة نووية ونفوذ مفقود في سوريا/ ضياء قدور
2025.05.25
في الذكرى السنوية لوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، أشاد المرشد الأعلى علي خامنئي بإرث رئيسي، مؤكداً أنه رفض بقوة أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. ورغم أن هذا الخطاب بدا كتكريم، إلا أنه حمل إشارة واضحة: المحادثات النووية الجارية مع واشنطن على وشك الفشل، في اعتراف ضمني بمأزق استراتيجي يواجهه النظام الإيراني. هذا المأزق، الذي يكشف عن هشاشة النظام، يتفاقم مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك تدخلاته المستمرة في سوريا حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
استراتيجية مألوفة: تحويل اللوم
تصريحات خامنئي ليست مجرد خطاب عابر، بل جزء من استراتيجية مدروسة للتنصل من المسؤولية عن فشل المحادثات النووية المحتمل. من خلال التأكيد على معارضته التاريخية للتفاوض مع الولايات المتحدة، يسعى خامنئي لتبرئة نفسه إذا انهارت الدبلوماسية. هذه الخطوة ليست جديدة؛ فقد شهدنا خلال إدارتي الرئيسين السابقين حسن روحاني ومحمد خاتمي نهجاً مماثلاً، حيث كان خامنئي ينسب الفضل لنفسه عند إبرام اتفاقيات، لكنه يسارع إلى إلقاء اللوم على المسؤولين المنتخبين و”عدم أمانة” أميركا عندما تفشل المفاوضات.
تصاعد التوتر وتضارب الخطوط الحمراء
تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً متزايداً في الأسابيع الأخيرة. أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى. في المقابل، أكد النظام الإيراني التزامه بمواصلة التخصيب دون تجاوز نسبة أربعة بالمئة، مما دفع خامنئي إلى الرد بغضب، واصفاً موقف الولايات المتحدة بأنه “هراء” ومتوعداً بعدم التراجع. هذا التصادم يكشف عن مأزق أساسي: ترى الولايات المتحدة أن أي تخصيب يشكل خطاً أحمر بسبب مخاطر التسلح، التي أثبتتها تصرفات النظام السابقة، بينما يعتبر خامنئي التخصيب ليس فقط حقاً سيادياً، بل مسألة كبرياء وأساساً لبقاء النظام الإيراني.
التخصيب كخط حياة استراتيجي
بعيداً عن الكبرياء، يلعب التخصيب دوراً استراتيجياً حاسماً بالنسبة لإيران. بالنسبة لخامنئي، الحفاظ على قدرات التخصيب ليس مجرد رمز، بل أداة ردع حيوية. مع ضعف وكلاء إيران في المنطقة وثبوت أن ترسانته الصاروخية أقل فعالية مما كان متوقعاً، يبقى احتمال تطوير أسلحة نووية بمثابة ورقة التفاوض النهائية للنظام في منطقة محفوفة بالعداء. لقد أحرزت إيران تقدماً كبيراً في قدراتها على التخصيب في السنوات الأخيرة، مما قلّص الوقت النظري اللازم لتطوير سلاح نووي. يخشى خامنئي أن تفكيك هذه القدرة سيترك النظام عرضة للخطر، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي، خاصة مع تزايد السخط الشعبي والأزمات الداخلية.
محادثات روما في مهب الريح
تعثرت أيضاً جهود إحياء الدبلوماسية. اقترحت عُمان، التي كثيراً ما لعبت دور الوسيط المحايد، استضافة جولة خامسة من المفاوضات في روما. لكن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، رفض الحضور، على ما يبدو بسبب توقعات بأن طهران ستضطر للرد على اقتراح أميركي يطالب بوقف التخصيب بالكامل. غير قادر أو غير راغب في تلبية هذا الشرط، اختارت طهران تأخير المحادثات بدلاً من مواجهة إنذار لا يستطيع قبوله.
المعارضة الداخلية والكلفة الاقتصادية
حتى داخل أروقة النظام الإيراني، بدأت أصوات المعارضة تظهر بشأن التخصيب. فقد خرج قاسم محب علي، المدير العام السابق للشرق الأوسط في وزارة الخارجية، عن الخط الرسمي، معلناً أن إيران لم تعد قادرة على الحفاظ على موقف “لا حرب ولا مفاوضات”. وقال: “لم نعد في وضع لا حرب ولا سلام”، محذراً من أن النظام يجب أن يتخذ خياراً حاسماً الآن. وانتقد محب علي الكلفة الاقتصادية الهائلة للبرنامج النووي، مشيراً إلى أن التخصيب استنزف أكثر من تريليوني دولار من الاقتصاد، بينما لم يساهم سوى بنحو واحد بالمئة من الكهرباء عبر محطة بوشهر. هذه التصريحات تعكس قلقاً متزايداً، حتى بين المقربين من طهران، حيال حكمة الاستمرار في سياسة جلبت المزيد من الألم مقارنة بالتقدم.
ردود فعل الأسواق تعكس الاضطراب
عكست الأسواق المالية هذه الهموم. بعد خطاب خامنئي الأخير، انخفضت قيمة الريال الإيراني بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الدولار بمقدار 2000 تومان ليصل إلى 84,000 تومان. ورغم محاولات وسائل الإعلام المرتبطة بالنظام، مثل صحيفة “كيهان”، تصوير هذا الانخفاض كدليل على موقف خامنئي القوي، فإن الحقيقة هي أن المستثمرين يستعدون لانهيار الدبلوماسية واستئناف العقوبات.
تدخلات إيران في سوريا: استمرار الفشل
لا يقتصر ضعف النظام الإيراني على الجبهة النووية أو العزلة الدولية، بل يمتد إلى تدخلاته في سوريا، التي استمرت حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد. لسنوات، دعم النظام الإيراني، عبر الحرس الثوري وفيلق القدس، ميليشيات طائفية أسهمت في إطالة الصراع وتعميق معاناة الشعب السوري. حتى بعد انهيار نظام الأسد، واصلت إيران محاولاتها للحفاظ على نفوذها في سوريا من خلال دعم بقايا هذه الميليشيات، لكن هذه الجهود لم تحقق سوى المزيد من الإنهاك لموارد النظام. هذه التدخلات، التي كانت تهدف إلى تعزيز الهيمنة الإقليمية، كشفت عن حدود قدرات طهران، حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها في ظل الضغوط الداخلية المتفاقمة والرفض الإقليمي المتزايد.
إيران عند مفترق طرق
يجد النظام الإيراني نفسه عند مفترق طرق. لا يستطيع التراجع عن مواقفه المتشددة دون أن يبدو ضعيفاً، ولا يمكنه الاستمرار في مساره الحالي دون المخاطرة بمزيد من العزلة والتدهور الاقتصادي. مع مطالبة الولايات المتحدة بوقف التخصيب بالكامل ورفض خامنئي التنازل، تتقلص نافذة الحل الدبلوماسي بسرعة. ظل الحرب، الذي كان قد أُزيح جانباً بفضل المفاوضات المؤقتة، يلوح في الأفق مجدداً، تاركاً النظام في مواجهة مصيره المحتوم: إما الاستسلام أو الانهيار.
تلفزيون سوريا
————————————ا
هيبة الدولة السورية أم هيبة السوريين؟/ أحمد جاسم الحسين
2025.05.25
قدمتُ مجموعة قصصية ذات يوم إلى وزارة الإعلام ، التي أحالتها بدورها إلى اتحاد الكتاب العرب، وبعد أشهر جاءني الرد برفض المجموعة ومما ورد في تقرير اتحاد الكتاب آنذاك: القصص تمسّ هيبة الدولة!
قدمتُ مجموعة قصصية ذات يوم إلى وزارة الإعلام، التي أحالتها بدورها إلى اتحاد الكتاب العرب، وبعد أشهر جاءني الرد برفض المجموعة ومما ورد في تقرير اتحاد الكتاب آنذاك: القصص تمسّ هيبة الدولة!
تساءلتُ يومها: ما هذه الدولة التي تضعف هيبتها مجموعة قصص قصيرة جداً؟ ألهذه الدرجة جدران الدولة هشة بحيث إن نصوصاً سردية تهزها وتضعف هيبتها؟ وفي لحظة فرح، بتُّ أسمي نفسي: الرجل الذي هزّ هيبة الدولة! وحين أمرّ بلحظات ضعف بشرية، أنظر إلى نفسي وأقول: يا زلمة أنت تضعف، أو يهزك حدث عابر، نسيت أنكَ هززت سمعة الدولة؟
لدى السجناء السوريين ذوي الخلفية السياسية حساسية خاصة من عبارة هيبة الدولة وهي غالباً ما تترافق في ذاكرتهم مع عبارتين أخريتين، حيث تلازمت لتوزيع الاتهامات عليهم في محاكم صورية: “إضعاف الشعور القومي والمس بهيبة الدولة ووهن نفسية الأمة” وباتت هذه الفقرة سلعة تباع وتشترى بين المحامين والسماسرة السوريين من جهة والقضاة من جهة أخرى، وباتت تلك الجمل أداة لقمع أي حالة معارضة في ظل النظام المخلوع!
العلاقة بين الدولة والمواطن تختلف باختلاف نظام الدولة، ففي البلدان ذات السلطة الشمولية والمخابراتية تكون العلاقة علاقة “الحيطان لها آذان”، خداع وإكراه وإجبار، لذلك تكون الهيبة مفروضة من الأعلى على الأدنى، من صاحب السلطة الذي يحسب نفسه ممثلاً للدولة على من لا يملكها، وهي علاقة تريح الأنظمة العسكرية لأنها لا تعرف طريقة سواها، ولا تفهم معنى الاستجابة الذاتية، أو القيام بأفعال المحبة والتطوع والرضا، بل الإكراه والأوامر! وبغير تلك الطريقة لا تشعر الدولة الأمنية أنها تمسك بالسلطة ولا تروق لها سواها!
أما الدولة المدنية الديمقراطية فإن لديها عيوناً مختلفة حيث إن هيبة الدولة تنبع من الرضا والاستجابة الذاتية واحترام القانون الذي كان للمواطن رأي في صياغته أو اقتراحه لأنه حاول أن يلبي متغيراً ما وينظمه ويضبطه كي يكون تنفيذه مطبقاً على الجميع.
العلاقة بين الدولة والمواطن عادة ما يكتنفها عاملان هما: القوة والرضا، والنظام السياسي الذي يستطيع أن يحقق تلك العلاقة مع مواطنيه وهو دليل من دلائل نجاحه.
هيبة الدولة في الأنظمة التي تحترم شعوبها من هيبة مواطنيها، لا انفصال بينهما، ولا يمكننا أن نطلب من المواطنين أن يحترموا دولة لا يشعرون أنهم جزء منها. وعادة ما يكون احترام هيبة الدولة رضائياً ولا يأتي بقرار أمني بل هو ثمرة شعور طويل من المواطنة ورضا عن قرارات الدولة وشعور غامر أنك جزء منها.
كيف نبني تلك العلاقة الجدلية اليوم في المشهد السوري بين استعادة هيبة الدولة وفي الوقت نفسه هيبة المواطن واحترامه وتقديره؟
احترام القانون وتطبيقه مثلاً؟
حين نرى أنه يطبق على الجميع وفيه خير للجميع، من هنا فإن الدول المدنية تهيء شعبها للمشاركة في صياغة القانون وضرورته وتشرح لمواطنيها فوائد الالتزام به، وهو يشعر أنه كان جزءاً من صياغته.
بناء مؤسسات للدولة تخدم المواطنين فيها أشخاص أكفاء هو جزء من هيبة الدولة، هل هذا ما نعثر عليه اليوم في سوريا؟ أم أن سلطة المحسوبيات هي السائدة؟
الثقة بين المواطن والدولة لا تبنى بيوم وليلة وهي ليست وليدة الخوف لأن الخوف يولد تنفيذاً شكلياً للقوانين ويلغي روح المبادرة.
كثر الحديث مؤخراً في سوريا عن أن تصرفات شريحة سورية ما في جغرافيا سوريا ما تمس بهيبة الدولة، فردّ فريق آخر بنوع من الشماتة: ماذا عن انتهاكات الجارة اللدودة؟ وهذا يشير إلى شرخ بين الدولة ومواطنيها، فالأصل أن يشعر كل سوري بالإهانة إن تعدت دولة ما على بلده، وليس ان ينتظر منها أن تخلصه من ظلم ما يعيش في أعماقه، الأمر أبعد من تخوين وإشارة وبحث في سمات شخصية لشريحة سورية ما، فنحن لسنا في زمان القبائل بل في زمن الدولاة والدولة لا تنظر إلى الخلف بل إلى القانون وتأمين الأساسيات التي تسعد مواطنبها وتحقق العدالة وليس الثأر.
هيبة السوريين ترتبط اليوم بالحفاظ على أمانهم واحترام مكانتهم وتأمين سبل العيش الكريم والحرية والعدالة وتفعيل عمل القانون. أما هيبة الدولة السورية فتكمن في احترام ممثليها ومؤسساتها واحترام الأنظمة وسيادة القانون والغيرة على كل شبر فيها.
السؤال مرة أخرى: هل يمكن أن نطلب من المواطنين السوريين أن يحترموا هيبة الدولة السورية إن لم يكونوا يشعرون أنهم جزء منها ومن مؤسساتها ونظامها السياسي؟
وعلى المقلب الآخر: هل يمكن أن نطلب من الدولة السورية أن تحترم هيبة مواطنيها وهم لا يقرون بنظامها السياسي ولا يحترمونه ويقومون بما يزعزع أمنه؟
هل من طريق بين الطريقين؟
أحسبُ أن الطرفين في الحالة السورية المعاصرة بحاجة للقراءة أولاً كي يزيلا اللبس ويتفاهما: المواطن عليه أن يتعرف مفهوم الدولة وواجباته وحقوقه وما هي حدود المرونة وما يريده من الدولة وما تريده منه. وممثلو الدولة بحاجة لقراءة أساليب الحكم الرشيد وأن يحسموا خياراتهم: هل يريدون بناء دولة أمنية مخابراتية قمعية متغولة؟ أم دولة رضا ومشورة وديمقراطية ومودة ورحمة وتعاون وعدالة وقانون وحوار وتبادل؟
السؤال المهم: هل تسمح ظروف ما بعد النزاع للدول الخارجة من حروب إمكانية تطبيق مثل هذه المفاهيم أم أن الظروف ظروف أمنية متغيرة والسماء متلبدة بالكراهية والتشكيك وعدم الثقة؟ ولا بد أولاً من تحقيق الأمان أولاً وحصر السلاح بيد السلطة المركزية؟
ويتبعه سؤال: هل يثق المواطن السوري أو عدد من المواطنين بتلك السلطة؟ هنا لا بد من حوار ونقاش وخطوات لبناء الثقة من الطرفين في غطار العدالة الانتقالية! ومعلومٌ أن بناء الثقة يحتاج إلى وقت ويجب أن تكنتنفه خطوات تبدّد الأوهام والمخاوف وعادة ما ينتظرها الناس من الدولة!
السؤال المكرر للسلطة السورية الحالية هو: أي نظام تريد أن تبنيه مع مواطنيك؟ هل تريد متابعة سيرة النظام السابق المتغول المتوحش؟ بحيث إننا استبدلا نظاماً متغولاً أفادت منه شريحة ما، واليوم يُبنى نظام آخر تستفيد منه شريحة أخرى مختلفة، وبالتالي نبقى ندور في فلك التغول والتوحش والاستبداد أم أن هناك نية لبناء دولة تليق بحضارة الشعب السوري وبالمنظومة العالمية؟
الإجابة لا تملكها الدولة وحدها، بل كذلك مدى رضا المواطنين السوريني ومطالباتهم ومشاركاتهم ومساعيهم لبناء ذلك النظام ودعوتهم لتطبيق القانون والالتزام به، وعدم حصر السلطات بيد شخص أو مجموعة شخصيات!
تلفزيون سوريا
———————————
ما بين اللامركزية والفيدرالية في سورية
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
يختلط، في النقاشات السورية التي تلت سقوط نظام الأسد، الحديث عن الفيدرالية واللامركزية، كما لو أنهما مصطلحان مترادفان. تارّة تُتهم الفيدرالية بأنها مشروع تقسيم، وتارّة يُقارب الحديث عن اللامركزية كما لو أنه مجاز لغوي للفيدرالية، ما يجعل من أي دعوة إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المركز والأطراف تهمة مسبقة بالانفصال. في الحالتين، يبدو أن المشكلة لا تكمن في المفاهيم نفسها، بل في السياق السياسي المُحمّل بالتوجّس، وفي ذاكرة السوريين التي لم تعرف من السلطة إلا شكلها المركزي الصارم. ولكن قبل أن نمضي في التقييم، من المفيد أن نفصل بين المفهومين، في جوهر علاقتهما بطبيعة الدولة، وبالسلطة، وبالهوية الوطنية.
اللامركزية، من حيث التعريف العملي، هي توزيع جزئي للصلاحيات داخل الدولة الواحدة، بحيث تبقى السيادة موحّدة، ولكن تُمنح الوحدات الإدارية (بلديات، محافظات، مجالس محلية) القدرة على اتخاذ قرارات في قطاعات محدّدة كالصحة، والتعليم، والخدمات. أما الفيدرالية، فهي نظام سياسي دستوري أكثر تعقيداً، تُوزّع فيه السيادة بين الحكومة المركزية والكيانات الفيدرالية، وتتمتع هذه الكيانات بدستور أو قوانين خاصة، أحياناً ببرلمان، وقوة أمنية، وقواعد مالية خاصة بها. والفرق هنا جذري، فالفيدرالية تعني أن الدولة مكوّنة من “وحدات سياسية” متمايزة، ولكنها متّحدة. أما اللامركزية فهي مجرّد إعادة توزيع للوظائف داخل بنية دولة موحّدة لا تتغيّر طبيعتها القانونية.
كل محاولةٍ في سورية لطرح الفيدرالية تُقابل برفضٍ مسبق. ليس فقط لأن الفكرة مرتبطة في أذهان كثيرين بمشروع انفصال، لكن الخطاب الوطني نفسه بُني تاريخياً على مركزية الدولة بوصفها خط الدفاع الأول ضد أي محاولةٍ للتجزئة. ما يجعل من كلمة “الفيدرالية” ثقيلة في الوعي السياسي السوري، حتى قبل أن تُفهم بتفاصيلها.
السؤال في سورية اليوم ليس كيف نمنع التقسيم، وإنما كيف نُنظّم واقعاً منقسماً أصلاً، ضمن عقد سياسي واضح، يضمن بقاء البلاد ضمن وحدة سياسية مع الاعتراف العملي بتعدّد مراكز القرار.
ينبّهنا ديفيد هيلد، في قراءته لتحوّلات الدولة الحديثة، إلى أن المركزية الصلبة التي نشأت في القرن العشرين لم تعُد صالحة لعالم تعدديّ. إذ لم تَعُد السيادة تعني الاحتكار الكامل للقرار، وإنما القدرة على التنسيق بين مستويات السلطة المختلفة، بشرط المساءلة والشفافية. هذا تماماً ما تفتقده سورية، وهذا ما يجعل من اللامركزية اليوم شرطاً للتماسك.
في التجربة الألمانية، لم تنتج الفيدرالية انقساماً، بل رسّخت التمثيل السياسي والاجتماعي على مستوى الولايات، وأوجدت نمطاً من “التنافس العادل” في تقديم الخدمات والتنمية. وفي العراق، رغم هشاشة الوضع الأمني، خفّف الاعتراف بكيانات متعدّدة (كردستان العراق نموذجاً) ضمن الدولة العراقية من حدّة المطالب الانفصالية. أما في لبنان، الذي لم يعلن يوماً عن كونه دولة فيدرالية، فغياب نظام لا مركزي حقيقي أو فيدرالي، جعل كل طائفةٍ تدير شؤونها عملياً خارج الدولة، ما ساهم في تآكل فكرة المواطنة الجامعة.
العقل المركزي الذي ورثه الجميع من زمن الأسد ما زال يحكم الخيال السياسي
رغم أن اللامركزية تُطرح اليوم وكأنها ابتكار حديث أو استجابة استثنائية لما بعد النزاعات، إلا أن جذورها تعود في التاريخ السوري إلى بدايات القرن العشرين. ففي 1922، وفي ظل الانتداب الفرنسي، طُرحت صيغة “الاتحاد السوري” بكونها ترتيبا إداريا ضمّ ثلاث وحدات: دمشق، حلب، والساحل. ورغم أن السياق كان استعمارياً ومشحوناً بنيات التقسيم، أشار هذا النموذج، ولو بشكل أولي ومشوَّه، إلى إمكانية إدارة الدولة بصيغٍ لا مركزية تمنح المحليات هامشاً من الصلاحيات. لكن المهم هنا ليس النموذج الذي فرضته سلطة احتلال، بل النقاشات التي أُثيرت في تلك المرحلة بشأن توزيع السلطات بين المركز والمحيط. فقد شهدت تلك اللحظة، على هشاشتها، ولادة تخيُّل سياسي في سورية عن إمكانات الحكم المحلي وتعدّد مستويات السلطة، وهو تخيُّل لم يُستكمل لاحقاً، لكنه ظلّ يلوح احتمالا مؤجّلا في ذاكرة التجربة السورية.
يذكّرنا الفقيه الدستوري الفرنسي، موريس دوفرجيه، بأن اللامركزية ليست نصّاً قانونياً، بل علاقة ثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وهذه العلاقة لم تنشأ في سورية في غالب المراحل، فظلّ التوجّس من المجتمعات المحلية أقوى من الرغبة في منحها إدارة شؤونها.
لا يكفي الحديث في سورية اليوم عن الفيدرالية بوصفها إعلاناً سياسياً، ولا عن الوحدة بوصفها قدراً مقدّساً. المطلوب إعادة تفكير جذرية في شكل الحكم، تُبنى على إدراك لتعدّد البنى الاجتماعية والثقافية، ولتفكك السلطة المركزية السابقة من دون قيام بديل شرعي متماسك. في هذا الفراغ، لا يمكن الركون إلى جهاز بيروقراطي مترهّل، ولا إلى مركزٍ يمسك الصلاحيات بلا أدوات فعالة. وحدها مقاربة عادلة وواقعية لإعادة توزيع السلطة يمكن أن تمنح السوريين فرصة لبناء دولة قابلة للحياة. ولا يزال ما طرحه بيير روسانفالون قبل عقدين عن “الدولة العادلة” صالحاً تماماً للسياق السوري، فالعدالة الإدارية شرط للثقة السياسية، وأي نظام لا يُعيد توزيع السلطة يصبح مع الوقت أداةً لتعميق الانقسام، ولو لم يكن يقصده.
المطالبة بالفيدرالية لا تعني بالضرورة رفضاً للوحدة، كما أن عدم الثقة بالمركز ليس جريمة سياسية. ثمّة من يرى في الفيدرالية وسيلة لحماية خصوصيته، وثمّة من يراها أفقاً لتحقيق مواطنة أكثر توازناً وعدلاً. وفي الحالتين، أي صيغة حكم عادلة يجب أن تُبنى عبر تفاهم وتفاوض يعترف بأن السيادة عقد اجتماعي متجدد، لا امتيازاً مغلقاً في يد سلطة واحدة. وسواء سميناها فيدرالية، أو لامركزية موسّعة، أو عقداً إدارياً جديداً، يتركّز جوهر النقاش اليوم حول استعداد السوريين لاقتسام السلطة بشكل عادل، أم أن العقل المركزي الذي ورثه الجميع من زمن الأسد ما زال يحكم الخيال السياسي.
لا يكفي الحديث في سورية اليوم عن الفيدرالية بوصفها إعلاناً سياسياً، ولا عن الوحدة بوصفها قدراً مقدّساً
في الظروف الحالية التي تعيشها سورية، لا توجد هيئة دستورية منتخبة أو مجلس تأسيسي يمتلك الشرعية الكاملة لصياغة شكل نظام الحكم الجديد، لكن هذا لا يعني أن الخيار بين الفيدرالية أو اللامركزية يجب أن يُحسم بتفاهمات فوقية أو ميزان قوى مؤقت. تقتضي المرحلة الانتقالية تأسيس مسار سياسي واضح نحو عقد اجتماعي جديد، يبدأ بتشكيل هيئة تأسيسية ذات شرعية تمثيلية نسبية على الأقل، تُبنى من خلال عملية تشاورية موسّعة بين قوى المجتمع المدني، والمكوّنات المحلية، والمجالس المنتخبة أو شبه المنتخبة إن وجدت، وبإشرافٍ أممي أو جهاتٍ ضامنة للانتقال. وهذه الهيئة، وإن لم تكن “منتخبة بالكامل” في المعنى الدستوري التقليدي، إلا أنها يجب أن تستمدّ شرعيتها من توازن واقعي وتوافقي، ومهمّتها الأساس صياغة مسودة دستور انتقالي أو دائم، يُطرح لاحقاً للاستفتاء الشعبي، ويحدّد فيه شكل الدولة، نمط الحكم، وقواعد تقاسم الصلاحيات.
… يجب أن يُبنى اختيار الفيدرالية أو اللامركزية على قراءة دقيقة لبنية الدولة والمجتمع، لتوزّع السكان، ولطبيعة الموارد، ولتجارب العيش المشترك في الماضي القريب. الفيدرالية، حين تُبنى على التوافق، قد توفّر استقراراً ذاتياً لوحدات جغرافية أو ثقافية تشعر بالتهميش أو القلق، وتشيع شعوراً بالانتماء الطوعي للدولة الجامعة. أما اللامركزية الإدارية، فإنها تمنح المجتمعات المحلية القدرة على إدارة شؤونها اليومية من دون المساس بالبنية السيادية للدولة، وتُعدّ أداة مرنة لإعادة التوازن بين المركز والأطراف.
في ظل سلطةٍ انتقاليةٍ هشّة، وبلد أنهكته المركزية العنيفة عقوداً، تبدو الحاجة ماسّة إلى فتح نقاش هادئ حول الخيارين، بوصفهما أدوات سياسية وإدارية يمكن أن تساهم في إنتاج عقد وطني جديد يُراعي التعدّد، ويعيد توزيع الثقة، ويجعل من الدولة حاضنة. الشكل النهائي يجب أن يُتوافق عليه عبر عملية تشاركية واسعة، ويُقرّ عبر دستور حيٍّ يكتبه السوريون بأيديهم، لا يُنسخ عن تجارب الآخرين، ولا يُصاغ لإرضاء قادة المرحلة الانتقالية.
العربي الجديد
——————————
السوريون وقميصُ عثمان المُدمّى
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
انطلاقاً من ضرورةِ ضبط إيقاع المخاض النهضوي العسير في المرحلة الانتقالية، شهدت سورية تغييرات سريعة منذ فرار بشّار الأسد، أهمها قرار رفع العقوبات الغربية الذي أعلنه دونالد ترامب في كلمةٍ له في الرياض، ليُعتبر الهدية الثمينة الثانية بعد إسقاط نظام الأسد، ويشكّل منعطفاً حاسماً في مسار الدولة والمجتمع يُعيد رسم علاقة سورية بالعالم من حولها، خصوصاً وأنّ الرئيس الأميركي أخبر أحمد الشرع أنّ لديه فرصة نادرة لقيامةٍ عظيمة في بلاده بعد منح شعبه بداية جديدة. وأقول: السوريون، بدورهم، يملكون فرصة تاريخية لن تتكرر لرفع ما هو ألعن وأكثر خطورة، وأقصد بالطبع القيود الطائفية.
في المقابل، شكّل القرار تطوراً دراماتيكياً هاماً فتحَ الباب أمام تساؤلاتٍ ملتهبة بشأن جدوى هذا التحوّل المفاجئ بالتوازي مع إرث النظام المخلوع وتداعياته على بلد خرج لتوّه من الجحيم، وعلى جنباته المُقفرة تنفجر الأحقاد المعلّقة، تحت مشاهد مذابح طائفية، أو صدامات ومظاهرات طائفية، بما يوحي وكأنّ سورية دخلت حقبة أبدية، لكن بسياقٍ آخر.
من هنا، من الدقّة بمكان الإشارة إلى أنّ ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة. ويبقى السؤال الملحّ أنه ووسط الفراغ الأمني الهائل القائم على الاستقطاب المذهبي والعرقي، كيف سيكون السوريون جديرين بكرم ترامب غير المسبوق؟ يرتكز الجواب على حفنةِ تفاؤل، خصوصاً وأنّ المُعطيات المتوفّرة، حالياً على الأقل، تؤكد أنّ الطائفية لن تكون المشكـلة التي ستعاني منها سورية المستقبلية اللامركزية، وهي تسير قدماً باتجاه “الفدرلة”، إنْ جرى تقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات حسبما أعلن عنه وزير الداخلية السوري في الآونة الأخيرة.
ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة
بالتساوق مع ما تقدّمـ يقع على عاتق السلطة الحالية مسؤولية خلق وعي سياسي ووطني ضمن فضاءات مدنية واسعة، لردع الخطابات الديماغوجية الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك المهرجانات الدعوية الكاريكاتورية والتجاوزات المستفزّة، التي لم تكن مجرّد تصرّفاتٍ خرقاء فردية من متديّنين متشددين ومتحمّسين، إذ كشف زخمها مستويات عالية لخطاب الكراهية والإقصاء، أيضاً تسويق مصطلحَي الأغلبية “المُباركة” والأقلية “المُدانة”، ما يمثّل عصياناً يمهد لحالة انقلابية على الهوية الوطنية الجامعة، وإشاعة حالة عدم يقين في وقتٍ تحتاج البلاد فيه إلى رأب التصدعات وهدم الجدران العازلة التي خلّفها النظام البائد، الذي روّج كذبة كبيرة أنه “حامي” الأقليات. لنتذكّر: عند تأسيس الجيش السوري عام 1945، نُقلت إليه كلّ مقدرات جيش الشرق البشرية، ومنها العلويون، الذين وجدوا أنفسهم بين الآباء المؤسسين للمؤسسة العسكرية، ولم يكونوا منبوذين ومضطهدين، كما ادّعى حافظ الأسد. وعلى السوريين اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، دحض تلك الأكاذيب، واستنكار المصطلحات المتداولة عن سُنّة أكثرية في دولة أموية يُعاد إنعاشها قسراً، بصفتها انحرافاً كارثياً عن طريق بناء بلد عابر للطوائف والأعراق.
فعلياً، لا توجد حساسية طائفية إلاّ عند من يتبنّاها ويسوّقها، بالتالي فإنّ التضخيم المغرض للسرديات الطائفية وارتفاع الأصوات المحرّضة، هدفه تسهيل الطريق لتمزيق النسيج الاجتماعي، بداية في الساحل السوري، ولاحقاً في البيئة الدرزية بعد التسجيل الصوتي المفبرك وتداعياته الكارثية، وعلى الطرف الآخر ترتفع نسبة شيطنة “الأكثرية” من قبل “أيتام الأسد”، وشيطنة “الأقليات” من قبل المتطرفين الحاقدين، إضافة إلى باقي الطوائف والإثنيات، خصوصاً الكردية التي لا تخفي مخاوفها الوجودية من المستقبل…إلخ، هذه الدوامة الطاحنة لم تُوقع السوريين في الفـخّ الطائفي المُحكم، بدلالة أنه وفي الوقت الذي تظهر به أصوات تتناول مجريات الأحداث المشتعلة بأبعاد طائفية وبلغة عنصرية مقيتة لا تخدم إقامة السلم الأهلي، تظهر أصوات مقابلة تُدين هذا “الزعيق الطائفي” وتسخّفه في مكان. وخير دليل على ذلك ملصقاتٌ عُلّقت في اللاذقية تدعو إلى تكفير العلويين، ليزيلها عقلاء من السنّة على الفور.
وعليه، التذكير بأسباب الطائفية ليس مجرّد اجترار مجاني للماضي وإنما إنعاش للوعي المغيّب بما يجب أنّ يُعلَمَ بالضرورة، ومن ثمّ، فإنّ استحضار أحداث حماة (1982)، مثلاً، والتي فعّلت نبرة الطائفية إلى الحدود القصوى بعدما كانت في مستواها الأول غير الملموس، مدخلٌ لازم للبحث في سُبل الشفاء من اللعنة السوداء التي فُرضت على السوريين وأصبحت ملازمة لهم، بعدما دفعهم نظام الأسد للتمسك بهوية إيمانية دوغمائية تضع الذات في مفارقة جدلية عقيمة مع الآخر المختلف لفرض حالة تضاد صدامي صالحة دائماً للاستثمار، ما يجعل اللوحة الفسيفسائية السورية المصطلح الأكثر ابتذالاً الذي عرفه السوريون يوماً.
نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم
بطبيعة الحال، يُجمع مراقبون على أنّ الطائفية بمزاجها المتشدّد دخيلةٌ على المجتمع السوري المتسامح نسبياً، ولا شك مرّت نزعة “الشِقَاق الوطني” بمحطات هبوط وصعود بلغت مداها في عهد نظام الأسد، الذي رعاها ضمناً وأنكرها علناً، معيداً ترتيب مفردات الاختلاف الطبيعي بين المكونات السورية لتخديم سلطته العميقة وتكوين آلته القمعية. وحين رُفع غطاء الجحيم عن البلاد أخيراً بإعلان نهاية حكم الأبد إلى غير رجعة ظهرت أمراضٌ مجتمعية ساهم في صناعتها، وهي، في جوهرها، ليست إلاّ سجال الألم وسعار الغضب اللذين ينتهيان دائماً إلى عباراتٍ سامّة، من قبيل “نحن” و”هم”. واليوم، وفي لحظة مفصلية حرجة تشهدها سورية والمنطقة، المتاح إما مصالحة وطنية تُنهي تراشق التهم الطائفية بين الأطراف المختلفة أو أن تغدو التحالفات والأيديولوجيات سبيلاً لتثبيت مشروع “أفغنة” الدولة، وهي أفضل السيناريوهات الممكنة حينها، أو لمشروع احترابٍ دموي دائم في أسوئها.
يتوجب الجزم بيقين أنّ المشكلة الطائفية لم تنشأ بسبب التنوّع وتناقض مصالح الطوائف، بل تكمن أساساً في الاستثمار السياسي فيها، ولا يمكن اجتثاثها من جذورها إلا بترسيخ أسس الديمقراطية الفعلية، بعيداً عن منطق المحاصصة. والواقع أنّ ضرب الخطاب الطائفي لن يتمّ إلا مع سقوط الحاضن الأول له، وأقصد تركة الأسد، على القدر نفسه من الأهمية، بوقوف السوريين جميعهم بحزمٍ ضد التخوين والعنصرية، خاصة تحريض سوريّي الخارج وقراءتهم مسبَقة الصنع للمشهد السوري، والذين انتقلوا بسرعةٍ مريبة من الانتقاد إلى مدافعين شرسين عن الحكومة الجديدة، لإيمانهم أنَّ “القوة دائماً على حقّ”. ولا نبالغ إذ نقول إنه ينطبق على الطائفية السورية توصيف “قميص عثمان المُدمّى”، الذي رفعه بنو أمية والنيّة المُضمرة لم تكن الثأر لعثمان، بل الوصول إلى نيل السلطان، واليوم تشهد الفضاءات السورية العامة ارتفاعاً مهولاً وممنهجاً في الخط البياني لخطاب العدالة “الانتقامية” بقصد الهيمنة والتمكين، ما يؤكد على رُدّة وطنية للوافدين من أماكن التطرّف، وربما القهر، وبذريعة الشعار الأكثر استبداداً “من يحرّر يقرّر”.
نافل القول: تراجع الأزمة السياسية سينجم عنه بالضرورة تراجع في التوتر الطائفي، أما التعامل معه، بوصفه تحصيل حاصل لما تقدّم ذكره، فضرورة ملحّة لا تستوجب الإنكار أو التأجيل، باعتباره آفة مارقة تجعل التسليم بزواله نتيجةً لا جدال حولها. بالتالي، نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم، لمواجهة خطر هذا الطاعون القاتل، ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، لأنه، ببساطة شديدة، مصدرُ تفرّق وعداوة ضدّ التنوع والاختلاف، وأيضاً ضدّ الحياة.
العربي الجديد
———————–
مَن نقَل الجولاني إلى الانفتاح؟/ فاطمة ياسين
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
ظهرت في الأيام الماضية محاضرة لدبلوماسي أميركي سابق، دعمتها تقارير، تفيد بأن أحمد الشرع تلقّى تدريبات من نوع خاص، وأن شخصيته الحالية المنفتحة على العالم تعود إلى دروس حضرها بانتظامٍ خلال سنوات وجوده في إدلب.. تنطلق هذه الطروحات من أن الشرع شخصية “ممنتجة”، جرى التلاعب بها عن طريق التغذية الإعلامية، والتثقيف الكثيف، كي ينتقل من حالة الجهادي الذي يؤمن بفكر القاعدة العنيف، والمتطرّف الذي يكفّر الآخر، إلى رجل متفهم للحاجات الدولية ومطالب المواطن في الداخل، ويستوعب وجود مذاهب وأديان ثانية، عليه النظر إليها مكوّناً وطنياً، يمكن أن يساهم في عملية البناء.. تبدو المهمة كما جرى عرضها صعبة جداً، فهي أشبه بعملية تغيير دماغ يجري فيها فتح الجمجمة والعبث بالمكوّن الفكري لتعديل مساره بالاتجاه المرغوب.. عرض المهمّة بهذا الشكل يحمل تدليساً ما، وربما كذباً واضحاً، لأسباب عديدة، منها طبيعة العلاقة التي جمعت أبو محمد الجولاني بالغرب عموماً، ووجوده على قائمة مطلوبين، وتصنيف جماعته ضمن قوائم الإرهاب.
صرّح الجولاني سابقاً إنه يحاول الاتصال بالغرب، وبشكل صريح تحدّث إلى صحافي أميركي يدعى مارتن سميث في مقابلة نشرها موقع “فرونت لاين” في بدايات عام 2021، تحدّث فيها عن ثورة ضد نظام الأسد، يحاول تنظيمها وتحديثها ورعاية كل لاجئيها. وكان صريحا منذ السؤال الأول حين أجاب بأن هذه المنطقة لا تشكل أي تهديد لأوروبا وأميركا، في رسالة بالغة الوضوح، إن ما يحدث هو حرب ضد ديكتاتور يعرفه الغرب جيّداً.. وبالفعل، لم يُسجَّل أي هجوم خارج الحدود السورية لهيئة تحرير الشام. وأظهر زعيمها الجولاني وجهاً مثيراً للدهشة عندما قال للصحافي إنه ومجموعته جزء من الثورة السورية، وقد اعترف بوجود فصائل أخرى تحمل التطلعات نفسها، وتنطلق من جبهاتٍ أخرى، فلم يتّهمها ولم يتحدّث عنها بسوء، بل قال إنها مثل تنظيمه تتطلع إلى الهدف نفسه.
واجهه الصحافي بسؤالٍ ظن أنه مُحرج عندما قال له إنه في العام 2014 تعهد بمحاربة الولايات المتحدة وحلفائها، وسأله: هل تغيّرت؟ لم يتنصل الجولاني من الاتهام، ولكنه عدّله بما ينسجم مع الوضع الذي أصبح عليه بقوله: لقد وجّهنا انتقادات للولايات المتحدة بالفعل، ولكننا لم نقل إننا سنهاجمها من سورية.. في تلك اللحظة، كانت شخصية أحمد الشرع قد اكتملت ووضعت خلفها الجولاني إلى الأبد، ولا يمكن لهذا النضوج السياسي المستوعِب متطلبات تلك المرحلة، وما سيليها، أن يكون قد تلقاه في محاضراتٍ أو جلسات تدريس، بل هو حالة طبيعية انطلقت من نقطةٍ وتطوّرت بفعل ما واجهته من ظروف صقلتها وبلورت فيها فكراً آخر. ولم تكن تركيا بعيدةً عن إدلب، عاصمة الجولاني، وقد رأى فيها وجهاً آخر للدولة التي يتطلع إلى بنائها، ما ساهم في تحوّل تلك الشخصية الجهادية التي تركت رداء حركة طالبان، ولبست ثوباً حديثا، واستطاعت التأثير على كل رؤوس التنظيم وحتى التنظيمات الأخرى المتحالفة معها، لتعديل الرؤية المتطرّفة نحو منظور وطني موحّد، وهو أمر لا يقدر عليه أي محاضرٍ أو خبيرٍ تنمية بشرية.
الغرض مما تروّجه تلك الشخصية الغربية مصادرة إنجازات سورية محضة، وعدم التطلّع إلى بروز حالاتٍ جديرةٍ بالملاحظة، قادرة على تحمّل المسؤولية، وعلى قدر كبير من فهم سياسية المنطقة، وقد خرجت من رماد الواقع ذاته الذي كان يغلي بالعنف والتطرف القائم على التديّن الأعمى والراديكالية الراغبة بالانتقام من الأطراف الأخرى، وتجاوزت ذلك كله بعمليةٍ اجتماعيةٍ وحقوقيةٍ أفرزت العدالة الانتقالية، وحملةٍ سياسيةٍ كبرى عبرت عواصم العالم، واتصلت بأطرافٍ عربيةٍ وإقليمية للمساهمة في رفع العقوبات بشكل كامل عن سورية، ولم يبق إلا أن تبرهن للجميع بأنها أصلية، غير مفبركة بالتغذية بالمحاضرات، وذلك بإطلاق شرارة تنمية وطنية حقيقية كبرى تصل بسورية إلى التغيير المنشود.
——————————
الإخوان والشرع: “هدوء تكتيكي” وصدام مؤجّل
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
منذ سقوط نظام بشّار الأسد وصعود النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، تبنّت جماعة الإخوان المسلمين في سورية خطاباً سياسيّاً هادئاً ومتّزناً، يكاد يلامس البراغماتية. يظهر هذا بوضوح في بيانات الجماعة وتصريحات مراقبها العام عامر البوسلامة، التي تعكس رغبة واضحة في دعم الاستقرار السياسي، وتوجيه رسائل تطمينية إلى الداخل السوري والدول العربية. بل لم تتردّد الجماعة في الإشادة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، وتقديم الشكر للسعودية على ما وصفته بدورها الإيجابي في هذا التحوّل.
مع ذلك، لا تعكس هذه الرسائل العلنية حقيقة العلاقة المعقّدة بين الجماعة والنظام الجديد، فخلف الأبواب المغلقة، تسود حالة من التوجس المتبادل. حتى اللحظة، لم يُرخَّص حزب الوعد (الحزب الوطني للعدالة والدستور)، وهو الذراع السياسية للإخوان، رغم محاولاته المستمرّة للعمل في إطار القانون الجديد. وتفيد مصادر مطلعة بأن هذا الرفض غير المعلن يعكس موقفاً محسوباً من أحمد الشرع تجاه الجماعة، يتجاوز المسائل الإدارية أو القانونية إلى اعتباراتٍ أعمق تتعلق بالتحالفات الإقليمية وسياقات الصراع الأيديولوجي.
في البعد المحلي، تظل العلاقة بين الجهاديين والجهاديين السابقين (يطلق عليهم كاتب هذه السطور مصطلح ما بعد الجهاديين) و”الإخوان” مشوبة بالتوتر وسوء الفهم المتراكم. الشرع، الذي خرج من عباءة العمل الجهادي وتحوّل سياسيًا، لا يُخفي، حسب بعض المقربين منه، عدم ارتياحه للتجربة الإخوانية. ويرى فيها مشروعاً سياسيّاً طويل النفس، ينافس على الحكم عبر أدوات شعبية وديمقراطية، لا من خلال العنف، ما يجعلها أكثر تهديداً في نظر أنظمةٍ كثيرة.
أما البعد الأهم فهو الإقليمي، فعواصم عربية عديدة مؤثرة عبّرت عن تحفظات واضحة تجاه الجماعة، واعتبرت أن أي انفتاح عليها في سورية الجديدة سيكون بمثابة إحياء غير مباشر لمشروع الإسلام السياسي، وليس سرّاً أنّ دولاً عربية عديدة ربطت موقفها السلبي، بدايةً، من الشرع وهيئة تحرير الشام بالخشية من أنّ التغيير في سورية سيؤدّي إلى عودة الإسلاميين، وأنّه (بحسب ما قاله لي دبلوماسي عربي سابق) بمثابة “قبلة الحياة للإسلام السياسي”، فالشرع يدرك تماماً أنّ تحسين علاقاته بالدول العربية والتطبيع معها ودعم هذه الدول النظام الجديد مالياً ودبلوماسياً وسياسياً مرتبطان بصورة أساسية بموقف حازم رافض لعودة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي من البوابة السورية، وبتجنّب أي علاقة مع نموذج الإسلام السياسي في العالم العربي. بل أكثر من ذلك، لم تتحسّن علاقة الحكومة السورية بدول عربية عديدة إلاّ بعد أن أخذت منها رسائل حاسمة من موضوع الإخوان المسلمين، وبوساطة وتأكيدات تركية على ذلك.
المفارقة الكبرى أن النظام الجديد، الذي خرج من عباءة هيئة تحرير الشام ويقودُه جهاديون سابقون، بات يحظى بقبول إقليمي ضمني، بينما يُقصى تيار أعلن مراراًُ قبوله بالديمقراطية والعمل السلمي. وتعكس هذه المفارقة قراءة عربية رسمية ترى أنّ الجماعات الجهادية تُعتبر تحدّياً ظرفيّاً يمكن احتواؤه أمنيّاً، في حين أن الإخوان المسلمين، بتنظيمهم العابر للحدود وأفكارهم السياسية، يمثلون تهديداً طويل الأمد.
يتعامل “الإخوان” بقدر عالٍ من الحذر السياسي. فهم يدركون طبيعة المرحلة، ولا يسعون إلى مواجهةٍ مبكّرةٍ مع النظام الجديد. لكنهم، في الوقت نفسه، يملكون من الخبرة والتنظيم ما يكفل لهم البقاء في الخلفية ريثما تتغير المعادلات. ومن المرجّح أن تعود الجماعة إلى الواجهة إذا ما فُتح المجال السياسي أو تغيّرت المعادلات الإقليمية.
في النهاية، تبقى العلاقة بين أحمد الشرع و”الإخوان” محكومة بتوازنٍ هشّ، أقرب إلى هدنةٍ تكتيكيةٍ من كونه توافقاً استراتيجيّاً. فهل سيطول عمر هذا التوازن، أم أننا على أبواب مواجهة مؤجلة يعاد فيها رسم مشهد الإسلام السياسي في سورية؟
———————————-
الملف السوري بين أنقرة وباريس.. نقاط الالتقاء والافتراق وآليات إدارة التنافس/ محمد كساح
24 مايو 2025
يستبعد الخبراء التوصل إلى حسم للتنافس الفرنسي التركي على الأراضي السورية، خاصةً في ظل حالة الافتراق الشاسعة الناتجة عن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية، مقابل التوجه التركي نحو تصفية ملف شرقي الفرات كونه يمثل أكبر تهديد للأمن القومي، من وجهة نظر أنقرة.
ومع ذلك، فإن اتجاهات باريس وأنقرة ليست مختلفة على طول الخط، بل هناك نقاط تلاق عديدة، حيث يشترك البلدان في ملفات مهمة داخل الإقليم.
“قسد” بيضة القبان
يرى المحلل السياسي درويش خليفة أن نقطة الالتقاء في العلاقات التركية الفرنسية هي محاربة داعش، وقد اشترك كلا البلدين في التحالف الدولي، كما تم التنسيق بينهما على أعلى المستويات بالنسبة لملف اللاجئين السوريين.
وفي المقابل، فإن جوهر الخلاف بينهما يتعلق بدعم فرنسا لقوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات، ويؤكد خليفة أن هذا الخلاف كبير جدًا، لأن تركيا تصنف “قسد” على قائمة الإرهاب، وهذا الخلاف يشكل انطلاقة التنافس بين البلدين في سوريا.
وبناء على ذلك، يرى خليفة أن قطع فرنسا لعلاقاتها مع “قسد” يمكن أن يشكل البوابة الرئيسية لعلاقات حسنة مع دمشق من جهة ومع أنقرة من جهة أخرى.
ويضيف خليفة أن ترميم العلاقة بين تركيا وفرنسا يتطلب مستوى رفيعًا من التنسيق لا سيما في سوريا، كما لا يمكن تناسي التنافس القوي بين البلدين على النفوذ غربي أفريقيا، مع أهمية إدراك التركة الفرنسية الكبيرة في القارة السمراء.
الحسم مستبعد
الخلاف الواسع بين باريس وأنقرة في سوريا يعني زيادة التنافس أو الصراع الناعم، لكن هل يمكن أن تصل الأمور إلى نقطة الحسم، بحيث تُكتب الغلبة في النفوذ لأحد الطرفين؟
يقول الدبلوماسي السوري السابق، تحسين الفقير، إن الحديث عن حسم للتنافس التركي الفرنسي هو أمر مستبعد، لأن التنافس يرتكز على تباين استراتيجي عميق في الرؤى والمصالح، سواء في سوريا أو شرق المتوسط.
ويضيف، في حديث لـ”الترا سوريا”، أن ما نشهده حاليًا هو إدارة توازن هش، تتحكم فيه معادلات متغيرة تشمل الولايات المتحدة، روسيا، وإيران، فضلًا عن تفاعلات داخل الاتحاد الأوروبي والناتو. لذلك من المرجح استمرار التنافس بصيغ متعددة، مع لحظات تهدئة ظرفية أكثر منها تسوية شاملة.
ويرى الفقير أن هناك عقبات عديدة تقف أمام الرؤية الفرنسية تجاه سوريا، أبرزها محدودية أدوات التأثير الميداني مقارنة بتركيا التي تملك قوات ونفوذًا مباشرًا داخل الأراضي السورية، وشبكة من الفصائل المحلية. كما أن فرنسا ليست فاعلًا وحيدًا في شرق المتوسط، بل تصطدم رؤيتها أحيانًا بعدم توافق أوروبي داخلي أو بفتور أميركي تجاه التصعيد.
ومن جهة أخرى، يوضح الفقير أن ضعف التنسيق الفرنسي مع بعض الفاعلين العرب مثل قطر، أو التغيرات في موقف الإمارات والسعودية مؤخرًا، يجعل الرؤية الفرنسية تصطدم بواقع إقليمي معقد.
ويلاحظ الفقير الرغبة الفرنسية في تثبيت موطئ قدم رمزي في مناطق النفوذ الأميركي، لكن دون الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا أو روسيا. نظرًا لأن الوجود الفرنسي ضمن التحالف يمنح باريس ورقة سياسية أكثر منها عسكرية، لتأكيد حضورها في مفاوضات ما بعد التسوية.
أي دور لباريس في الملفات العالقة؟
في ضوء ما تورده التقارير حول تعزيز فرنسا لنفوذها العسكري بالموازاة مع الخط الدبلوماسي النشط في سوريا، يبدو لعب باريس لدور مهم في بعض القضايا العالقة مسألة محتملة، فهل يمكن أن نشهد دخول فرنسا في قنوات تفاوضية غير معلنة لتخفيف التوتر بين تركيا و”قسد”، بالتوازي مع تقريب وجهات النظر بين الإدارة الذاتية ودمشق؟
في معرض إجابته على السؤال، يرى تحسين الفقير أن فرنسا تدرك أن المواجهة المباشرة مع تركيا غير مجدية، لذلك لا يُستبعد أن تسعى عبر قنوات خلفية إلى نوع من “ترتيب المصالح” يحدّ من التصعيد، خاصة مع وجود أطراف مثل واشنطن وبرلين تسعى لمنع تفكك التحالف ضد داعش.
من جانبه يستبعد درويش خليفة أن تمارس باريس أي دور فعلي في تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية و”قسد”، انطلاقًا من أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي للمفاوضات، كما أنها تضغط باتجاه إتمام كل الاتفاقيات الحاصلة بين الطرفين، وإذن فلا مبرر لوجود طرف آخر ربما يكون معرقلًا أكثر من كونه صاحب دور إيجابي.
الترا سوريا
————————————–
ميثاق الإعلام السوري الجديد: نحو إعلام مسؤول يتجاوز السلطة والأيديولوجيا/ مالك الحافظ
24 مايو 2025
إن مقاربة موضوع ميثاق الإعلام السوري الجديد تتطلب قراءة معرفية تفكيكية تضع هذا الميثاق ضمن سياق الدولة الهشة ما بعد الحرب، وتفحص علاقته بالبنى السياسية والاجتماعية العميقة التي يعيد الإعلام تمثيلها وصياغتها.
والحاجة إلى ميثاق إعلامي لا يمكن اختزالها في مجرد إعلان التزام بالقيم التقليدية مثل حرية الصحافة، إنما تكمن في تأطير العلاقة بين الإعلام والمجتمع بوصفها علاقة تعاقدية مركبة تستبطن مفهومًا واسعًا للمسؤولية الجماعية.
وفي لحظة سياسية ومجتمعية مشوشة مثل اللحظة السورية الحالية، قد يبدو الحديث عن ميثاق إعلامي شامل أقرب إلى استحقاق مؤجل منه إلى مشروع جاهز. قد لا يظهر في الواقع السوري الحالي بيئة واضحة قادرة على احتضان مثل هذا النوع من التعاقد الأخلاقي أو المعرفي، وسط هشاشة الدولة الوليدة، وصعود سلطات فوق–دولتية قد تساهم أو تؤدي إلى اختراق المجال الإعلامي بخطاباتها وأدواتها.
ومع ذلك، فإن الضرورة الأخلاقية والمعرفية تفرض نفسها، فالتفكير المسبق بمضامين الميثاق يتحول إلى شرط من شروط إعادة بناء المجال العمومي الوطني، متى سنحت اللحظة السياسية القادمة بذلك، والتفكير النقدي المسبق هو ما يضمن ألّا تبدأ المرحلة الجديدة في فراغ مفاهيمي أو تنظيمي.
الإعلام في البيئات الانتقالية ما بعد النزاع، كما في الحالة السورية، لا يُفهم كمجرد ناقل للأحداث أو مراقب للسلطة، وإنما يُعتبر فاعلًا بنيويًا أساسيًا في مشروع إعادة بناء الدولة، فيلعب الإعلام دورًا مباشرًا في إنتاج السرديات الوطنية وصياغة الخيال الجمعي وتوجيه النقاش العام، ما يجعله عنصرًا فاعلًا في الديناميات السياسية والاجتماعية. هذا الدور يفرض على الميثاق الإعلامي أن يُصاغ باعتباره وثيقة تعاقدية تحدد موقع الإعلام ضمن هندسة المجال العمومي وضمن تصور معرفي يأخذ بالحسبان تعقيدات البيئة الانتقالية وتشابكاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلام في السياق السوري الراهن لا يُقرأ كمجرد أداة نقل معلومات أو مراقبة للسلطة، إنما هو بنية أساسية في صناعة المجال العمومي كما صاغه يورغن هابرماس، بما يحمله ذلك من بعد تداولي يتطلب قواعد ملزمة تضمن التعددية والشفافية وإدارة الخلافات ضمن حدود أخلاقية واضحة. من هذا المنطلق، فإن الميثاق الإعلامي يتجاوز كونه نصًا إرشاديًا، ليصبح تعبيرًا عن مشروع لإعادة تعريف وظيفة الإعلام ودوره في مرحلة ما بعد الصراع.
المبادئ الجوهرية.. نحو تفكيك الأسس المعرفية
لا يكفي الحديث عن مبادئ مثل الاستقلال أو الشفافية بمعناها الإجرائي فقط. المقاربة المعرفية تقتضي النظر إلى هذه المبادئ كمحددات بنيوية تعيد تنظيم موقع الإعلام السوري داخل السلطة والمجتمع. الاستقلال هنا لا يعني فقط الانفصال عن السلطة السياسية، بل يشمل مقاومة سطوة رأس المال الإعلامي والتأثيرات الأيديولوجية التي تحول المؤسسات إلى منصات استقطاب. أما الشفافية، فهي لا تختزل في الإفصاح عن مصادر المعلومات، بقدر ما تقتضي مقاربة شاملة تجعل من آليات العمل التحريري والتمويلي والسياسي موضوعًا قابلًا للفحص والمراجعة.
ولا ينحصر رفض خطاب الكراهية في منع الألفاظ العدائية أو المواد التحريضية المباشرة، فهو يشمل تحليل البنى السردية والتمثيلات الإعلامية التي تعيد إنتاج الانقسامات العرقية والطائفية والمناطقية.
ويقتضي احترام الضحايا سياسات تحريرية تحمي كرامة الأشخاص المتأثرين بالنزاعات، بما يعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الرمزية. كما أن الاعتراف بالتعددية لا يُختزل في التمثيل الشكلي للمكونات المختلفة، بل يستدعي بناء بنية خطابية تحتضن اختلاف الروايات وتمنحها مساحة عادلة في المجال العمومي.
المبادئ الجوهرية التي يُفترض أن يحملها الميثاق لا تُواجه فقط تحديات المؤسسات الإعلامية التقليدية، إنما عليها أيضًا أن تعالج تحديات الإعلام الرقمي المفتوح، حيث تتقاطع أخلاقيات الصحافة مع أنماط جديدة من التعبير الشعبي، والتضليل المتعمد، والحملات الموجهة. إن صياغة بنود واضحة حول مسؤولية الصحفيين والمؤسسات في التحقق من المعلومات على المنصات الرقمية، ومساءلة الحسابات المؤثرة، ووضع معايير لنشر المواد الحساسة على السوشيال ميديا، تشكل جزءًا أساسيًا من تحديث الميثاق ليُصبح صالحًا لعصر الإعلام الهجين.
في هذا السياق، يبرز مفهوم “العدالة الرمزية” الذي طوّره علم الاجتماع الإعلامي بوصفه عنصرًا محوريًا في فهم وظيفة الإعلام ما بعد النزاعات، فالعدالة الرمزية تعني الاعتراف برمزية الضحايا والجماعات المهمشة ضمن الخطاب الإعلامي. والميثاق الأخلاقي بهذا المعنى لا يُفهم فقط كوثيقة لضبط السلوك المهني، يجب أن ينطلق من مفهوم تعزيز الاعتراف العام بحقوق الذاكرة الجماعية وإعادة الاعتبار لمن تم تغييبهم أو تشويه حضورهم حاليًا في المجال العام.
المقاربة التفكيكية هنا ترى أن القيم الكبرى للميثاق، مثل الاستقلال، والشفافية، ورفض الكراهية، واحترام الضحايا، والاعتراف بالتعددية، لا بد أن تُعاد صياغتها بما يتناسب مع السياق السوري، بحيث تتحول من شعارات عامة إلى محددات بنيوية ذات معانٍ واضحة وقابلة للقياس والمساءلة.
رفض الكراهية ينطوي على تفكيك السياقات التي تُنتج الصور النمطية، واحترام الضحايا يُعاد تأسيسه عبر سياسات تحريرية تحمي كرامة الأشخاص بدلًا من الاقتصار على الشعارات. التعددية تُعاد قراءتها كإطار تأطيري شامل يمنح أصوات الروايات المهمشة والمغيبة مكانًا عادلًا في النقاش العام.
تثير النقاشات الحديثة في دراسات الإعلام النقدي مسألة “حياد الصحافة” بوصفه مفهومًا إشكاليًا، خصوصًا في السياقات الانتقالية، فوفقًا لمدرسة الإعلام العامي ومقاربات الإعلام الاجتماعي، لم يعد الحياد يُفهم كموقف متفرج خارجي لا ينحاز، بل كقدرة المؤسسة الإعلامية على تحديد موقعها المعرفي–الأخلاقي ضمن ديناميات القوة والصراع. الميثاق الأخلاقي هنا يحتاج إلى إعلان واضح للموقع، والاعتراف بالانحياز إلى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة.
من يصوغ الميثاق؟
تجربة الميثاق الإعلامي في السياق السوري تثير إشكالية أساسية تتعلق بهوية الجهة الصانعة لهذا النص. التوجه المؤسساتي يحمل معه ثقل الشرعية والإمكانيات التنظيمية، لكنه يحمل أيضًا خطر الارتهان للسلطات السياسية أو الممولين. في المقابل، المبادرات المستقلة تقدم مساحات للتجريب وتوسيع هامش الحرية، لكنها أيضًا قد تعاني من ضعف القدرة على فرض الإلزام، أو غياب البناء المؤسسي المستدام.
يستدعي الإطار النظري هنا مفهوم الحوكمة التشاركية الذي يجمع بين قنوات الإنتاج المؤسسي والفضاءات المستقلة، بما يسمح بإنتاج ميثاق يحمل شرعية تعددية ويعبر عن المجال العمومي الواسع وليس فقط عن نخب الإعلام التقليدي.
تُظهر التجارب المقارنة، لا سيما جنوب إفريقيا وتونس، أن كتابة الميثاق الإعلامي لا تنجح إلا ضمن هندسة تشاركية تجمع النقابات الصحفية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الأكاديمية والمجالس الإعلامية المستقلة وممثلي الضحايا والأقليات. إنتاج الميثاق ضمن هذه البنية التشاركية يضمن أن تصبح الوثيقة مشروعًا تأسيسيًا جماعيًا يُعبّر عن المجال العمومي الواسع بمختلف أصواته.
إن وجود ميثاق أخلاقي دون آليات رقابية ومحاسبية يجرده من محتواه العملي. لذا فإنه وفق نظرية الأنظمة المعقدة، لا يمكن لإطار معياري أن يصمد في بيئة ديناميكية ما لم يُدعَم بشبكة من الآليات القابلة للتكيف والمراجعة المستمرة. على سبيل المثال فإن تجربة جنوب أفريقيا في إنشاء مجلس الصحافة المستقل بعد نهاية الفصل العنصري أظهرت أن نجاح الميثاق ارتبط بوجود جهة مستقلة قادرة على استقبال الشكاوى، والتحقيق فيها، وفرض توصيات علنية. وفي السياق العربي، تقدم تونس نموذجًا مهمًا لدراسة إعادة بناء الميثاق الإعلامي في بيئة انتقالية.
بعد الثورة، واجه الإعلام التونسي تحديات إعادة تعريف وظيفته وضبط علاقته بالسلطة الجديدة والمجتمع المدني، وشهدت البلاد نشوء هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، التي لعبت دورًا أساسيًا في ضبط وتنظيم الخطاب الإعلامي ضمن إطار يعمل على مأسسة الرقابة الذاتية وضمان التعددية والشفافية.
يبقى أحد التحديات الكبرى في صياغة الميثاق الإعلامي السوري الجديد هو إدماج الإعلام الرقمي ومنصات السوشيال ميديا ضمن الإطار الأخلاقي. هذه المنصات كسرت الحدود التقليدية بين المنتج الإعلامي والجمهور، وألغت الحواجز المهنية القديمة، ما يخلق الحاجة إلى ميثاق يتجاوز المنصات التقليدية ليشمل المؤثرين الرقميين، والمدونين، ومنتجي المحتوى الشعبي. من دون هذا التوسع، سيفقد الميثاق جزءًا كبيرًا من قدرته على التأثير في المجال العمومي، إذ أصبحت السوشيال ميديا اليوم فاعلًا مركزيًا في تشكيل الرأي العام، سواء عبر نشر المعلومات الموثقة أو عبر نشر التضليل الخطير.
البُعد المعرفي للمشروع
صياغة الميثاق الإعلامي لا تكتمل من خلال الحس الأخلاقي وحده، وإنما تحتاج إلى إطار مرجعي معرفي صلب، مستمد من حقول دراسات الإعلام والاتصال، نظرية المجال العمومي، فلسفة الأخلاقيات المهنية، ودراسات العدالة الانتقالية. إدراج هذا الإطار المرجعي داخل بنية الميثاق يمنحه قوة معرفية واضحة، ويحول الوثيقة من توصيات مهنية عابرة إلى عقد معرفي يحمل تصورات دقيقة حول وظيفة الإعلام ومسؤولياته وحدوده وآليات مساءلته.
الميثاق الإعلامي السوري الجديد هو مشروع تأسيسي يُعيد رسم موقع الإعلام في لحظة التحولات العميقة التي تعيشها البلاد. الوثيقة لا تكتمل إلا عند تحولها إلى مشروع عمل معرفي – مؤسساتي يتضمن وضوحًا في الرؤية وجرأة في المواجهة.
إن ميثاق الإعلام السوري الجديد يجب أن يُفهم كجزء من عملية أوسع لإعادة بناء المجال العمومي الوطني، فيما يبقى السؤال الجوهري متعلقًا بمدى استعداد الفاعلين الإعلاميين والمجتمعيين للدخول في هذا العقد المعرفي الجديد. هل هناك إرادة جماعية تذهب نحو تأسيس إعلام مسؤول يُسائل السلطة والأيديولوجيا في آن معًا؟ هل هناك وعي كاف بأن الإعلام أداة رقابية وبنية تشارك في صياغة الخيال الوطني؟ هذه الأسئلة لا تملك إجابات جاهزة، لكنها تفتح أفقًا ضروريًا لكل محاولة تفكير نقدي في مستقبل الإعلام السوري.
من دون مواجهة هذه التحديات البنيوية والسياسية، سيبقى كل حديث عن الميثاق الإعلامي محصورًا في الدوائر النظرية، لكنه مع ذلك لا يفقد قيمته كأداة إعداد معرفية واستباقية. فالقدرة على رسم خريطة للأولويات الأخلاقية والمهنية، وبلورة خطاب نقدي متقدم حول موقع الإعلام في الدولة الانتقالية، يمنح الفاعلين الإعلاميين فرصة صياغة مشروع مؤجل لكنه أساسي. هو مشروع يعيد تعريف وظيفة الإعلام في سوريا كبنية تصنع المعنى، وتعيد ترميم العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الذاكرة الوطنية والمجال العمومي.
الترا سوريا
————————————-
==========================
عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 25 أيار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
—————————
التعافي من تركة الآثام/ محمد برو
2025.05.25
على مدى أربع وخمسين سنة حكم الأسد الأب والابن سوريا بقبضة حديدية، وممارسة أمنية أشبه ما تكون بالكلاب المسعورة، في تتبع أدق الزوايا في الحياة السورية وتهشيمها، وإعادة صياغتها على نحو يخدم الاستبداد والحاكم الفرد. لم تستثن هذه الملاحقات الستالينية أي منحى من مناحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، وبدأت في تشكيل الأشواه التي تخدم سلطتها منذ سني الطفولة الأولى، مرورا بسنوات الشبيبة واتحادات الطلبة وهلم جرى، وجعلت الفساد والمنظومة المبررة له أو المشرعنة له جزء من الثقافة اليومية للعامة والخاصة، كما أنتجت لغة ومفردات ما أن تسمعها حتى تعلم أنك تكرر سماع ما سمعته آلاف المرات، دون أن يكون له أي معنى أو دلالة سوى استغباء السامعين ودفعهم لطأطأت الرؤوس ورفع الأيدي بالقبول، علاوة على كل ما سلف جرى تدمير للقيم الاجتماعية التي تشكل في لحظات الضعف سندا وداعما، تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحول دون الانهيار الكارثي السريع، كما حدث في المجتمع السوري بكافة طبقاته وشرائحه، وبات التفسخ الاجتماعي وانهيار منظومة الأسرة وفقد الثقة والأمان العامين، السمة الظاهرة في هذا المجتمع المدمر، الذي فتكت به الفاقة والعوز أشد الفتك.
واليوم وبعد سقوط هذا النظام ورحيل رموزه الكبيرة، تسرب الوهم إلى بعضنا أننا أنهينا بكفاح مرير حقبة سوداء من تاريخ سوريا، وأننا في تشوف كبير لبناء سوريا جديدة مختلفة بالكلية عن سوريا الضحية، غافلين أو متغافلين أن تلك النبتة الخبيثة التي زرعها نظام الأسدين، أنتجت بذورا وأبواغا وطبعت نفوسا، وكرست أنماطا من الممارسات ربما نحتاج لعقود كي نكون متعافين من عقابيلها، فخلال مئات الحوارات والمتابعات تجدنا ما أن تعترضنا عقدة أو عقبة، حتى يسارع مخزوننا الأسدي المتراكم عبر ما ينوف عن خمسين سنة، ليقترح الأنماط المخزونة من تلك الحلول التي سادت في تلك الأيام المنصرمة ( توسط لدى مسؤول دفع مبالغ تفتح الأقفال، اللجوء إلى احتيال قانوني يمرر الممنوع، التهديد بالقوة وممارسة العنف) حتى في انتقاد الفوضويين أو المعارضين الذين يهددون استقرار البلاد اليوم، تتكرر ذات العبارات التي كانت سائدة خلال العقود السابقة، في تجريمهم ووسمهم بالخيانة والعمالة وما لا يحصى من أدوات القتل والإقصاء اللفظي.
في فترة حكم الأسدين عمل النظام ونجح، في تكريس انقسامات طائفية ما تزال إلى هذه الساعة من أقوى محرضات النزاع وتأجيجه واحالة الكثير من الأزمات إليه، سيما أن بعضها مثقل بحمولات ثأرية لانتهاكات وجرائم ارتكبت على مدى عشرات السنين، وارتفعت وتيرتها بمذابح ومجازر شنيعة خلال العقدين الأخيرين، وهذا يدخل البلاد فيما يسمى بالحلقة المعيبة التي يدور السالك أو الغارق فيها دون القدرة على التوقف أو التقاط نقطة البداية والنهاية، ولا بد هنا من اجتراح فعل استثنائي يتجاوز منطق الحق والعدالة ويرتفع عنهما، لإيقاف دوامات الكراهية والعنف والتخندق الضيق، ولن ترضي هذه الحلول الاستثنائية الشطر الأكبر من المتضررين، لكن لا بد من التضحيات في طريق الصعود من الهاوية، ولن يجري الانتقال من بيئة الشحن الطائفي واستدعاء حوادثها السابقة، وما تستلزمه من مشاعر عدوانية تثوي تحت جلود الكثيرين منا، بمجرد التنديد بها أو إدانتها.
هناك طريق طويل وشاق سلكته أمم قبلنا حتى ترسخت لديها معايير المواطنة والاحتكام إلى القانون الذي يساوي بين الجميع، صحيح أن هذا الحلم لم ينجز على نحو تام لا في الشرق ولا في الغرب، لكن شعوبا واسعة باتت اليوم تعيش الشطر الأكبر من هذا الإنجاز، يتطلب هذا التحول العميق والطويل إرادة عنيدة من السلطات الحاكمة والاتجاهات الثقافية والمؤسسات التربوية والإعلامية، ونحن نشهد اليوم مدى قوة التأثير التي تمتلكها الدراما وسائر الأدوات الفنية في خلق اتجاهات ثقافية تلهب الشباب وتدفعهم للتماهي بها.
هكذا تنتصب أمانا اليوم أصنام لثلاثي الشر، “التخندق الطائفي أو الإثني، الفساد الذي أصبح جزء من منطق وطبيعة الأشياء، شبح الانتقام لمئات آلاف الضحايا الذين ينتظرون العدالة الغائبة وربما تكون المستحيلة” في لحظة تحاول فيها سوريا الجديدة ان تنهض من مستنقعات تركة الآثام التي يصعب حصرها أو النجاة من دماملها المتقيحة، هذا ونحن نضرب في حديثنا صفحا عن التركة الكارثية للآثار الاقتصادية التي سيدفع سائر السوريين ثمنها عقودا في ترميمها والخلاص من تبعاتها.
وإذا أوغلنا قليلا سنجد صحارى سوداء من الآثار النفسية المدمرة، التي يكاد ينجو منها النذر اليسير، والتي ستطبع أرواحهم لسنوات طويلة، فقد شكل النزوح المستمر والتهجير والاعتقال ودوامات العنف شعورا جمعيا عميقا بالخوف والرعب المهيمن، حتى على عالم أحلامنا، وتضاعفت حدة الاكتئاب عند الشريحة الأوسع، وبات نمط اللامنتمي الهروبي والانعزالي والظواهر الانسحابية سمة مألوفة ومفهومة عند الكثيرين، وأصبح القلق والسوداوية والاغتراب الاجتماعي وفقدان الأمل، سمة مشتركة وسائدة.
عملت راوندا وجنوب إفريقيا ودولة المغرب على آليات مستحدثة، للتعافي من الآثار الاجتماعية والنفسية لدى مجتمع أنهكته الحروب والأزمات وحكم الفرد المستبد، من خلال لجان الحقيقة والمصالحة ومن خلال منصات للضحايا والشهود ولجان الاعتراف بالحقيقة وطلب الصفح والمسامحة، أيضا محاكم مجتمعية “غوتشا” في راوندا، وهناك بلدان أخرى اجترحت حلولا أو مسارات خففت من جراحات الماضي، وتركت الباب مفتوحا أمام فرصة مجتمعية واسعة للنجاة من عبئ الجرائم وعبئ الاقتصاص من المجرمين، وقدمت في تلك التجارب نماذج ناجحة في تغليب المصلحة العامة على الحق الشخصي، لكن هذا لم يحدث عنوة أو جبرا بل جرت حوارات وتواطأت اتجاهات وقوى وطنية ومثقفون وقادة رأي، على جعلها أقل الحلول ضررا على مستقبل البلاد وأهلها.
ولليونان وإسبانيا تجارب مختلفة وناجحة في التعافي من آثار الحكم العسكري والملكية، ولن يكون بإمكان السوريين تقليد أي نموذج من هذه النماذج الآنفة، بل إن النماذج الآنفة الذكر لم تكن تقليدا لنماذج وتجارب سبقتها، بل هي ابتداع صرف تمليه طبيعة الأزمة وطبيعة السكان الخاصة والظرف الزمني ومحصلات القوى اللاعبة في هذه الساحة، واستعداد الناس وقابليتهم للانسجام مع هذه الحلول، وهكذا سيكون الأمر لدى السوريين، ستكون هناك حلول تنبعث من رحم الواقع وخصوصية الأزمات، تلبي الاتجاه العام والمطلوب للخروج من مستنقع الدوامات، وتكسر مساراتها الصعبة. ستكون الشجاعة المفرطة باقتراح الحلول بمواجهة المنطق السائد للعدالة وحقوق الضحايا، سيكون هناك خلاف وربما صراع طويل لترجيح أحدهما على الآخر، وستكون الحلول جميعها منقوصة ومعتلة ومفرطة بحقوق جانب من المصلحة لتحقيق جوانب أخرى، ولا مناص من البدء واتخاذ القرارات الشجاعة والعمل على خلق ثقافة قبول وتفهم لها، وإلا سنجتر آلامنا وحقوقنا المؤجلة وسنبقى في صراع طويل بين أحقية الأمن والسلام أو أحقية إنفاذ العدالة.
تلفزيون سوريا
—————————-
الساحل السوري… سقط النظام فتزايدت الهجرة!/ كمال شاهين
“لو بقينا هنا، سنكون إما جثثاً في أخبار عاجلة، أو أطباء بلا دوامٍ أو أدوية”، هذا ما يقوله الطالب في كليه الطب من مدينة بانياس، أحمد زاهر، في هذا التحقيق الذي يسلّط الضوء على تزايد أعداد الساعين إلى الهجرة في الساحل السوري، من دون أن تكون المجازر الأخيرة السبب الوحيد، بل تضاف إليها أسباب أخرى اقتصادية اجتماعية في ساحلٍ لم يعد يتعرّف على هويته.
22 أيار 2025
(الساحل السوري). “كل ليلة، أضع رأسي على الوسادة وأسأل نفسي: هل أموت غداً برصاصٍ عشوائي، أم أخاطر بركوب البحر لأموت غرقاً؟”. يقول ياسر زاهر (25 عاماً) الذي فقد ثلاثة أصدقاء في مجازر في منطقة بارمايا في ريف بانياس.
السؤال نفسه، يطرحه بصيغةٍ أخرى خرّيجُ كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة تشرين تمام (24 عاماً)، قائلًا لحكاية ما انحكت: “بعد كل ما حدث، لم يعد السؤال هل نغادر؟ بل متى نغادر؟”. يقول ذلك وهو يبحث ضمن مجموعةٍ على تيليغرام، اتفق مع مجموعةٍ من أصدقائه على وضع كلّ أخبار الهجرة فيها. المفارقة أنّ تمام ينتمي إلى جيل كان يُفترض أن يحتفل بـ”سقوط النظام”، لكنه اليوم يجد نفسه، وفي ظلّ أجواء مشحونةٍ بالخوف وعدم الاستقرار والإشاعات اليومية، أمام سؤال: لماذا تتفاقم أحلام الهجرة في الساحل رغم زوال نظام الأسد؟
وكما حدث قبل أربعة عشر عاماً عندما ملأ سوريون آخرون القوارب والمخيّمات والسفارات بحثاً عن فرص للنجاة، فإنّ هناك اليوم من ينتظر دوره في قوارب ومخيّماتٍ جديدة. من بين هؤلاء آلافٌ من سكان الساحل السوري لا يفكرون اليوم سوى في الهجرة للنجاة بأرواحهم وسط مستقبلٍ مظلم بدل انتظار موتٍ مجاني. هذه المرّة تبدو ضرورة الهجرة أمراً وجودياً تُغذيه الدوافع الاقتصادية والاجتماعية أيضا، لأنه “لو بقينا هنا، سنكون إما جثثاً في أخبار عاجلة، أو أطباء بلا دوام أو أدوية”، كما يقول الطالب في كليه الطب من مدينة بانياس، أحمد زاهر، مستعيداً بعض صور زملائه من الطائفة العلوية في حي القصور: “قُتل ما لا يقل عن عشرين طبيباً في الأسبوع الأسود في بانياس ومعهم عشرات المعلمين والطلاب، واختفى عددٌ غير معروف منهم. ليس من المعقول أبداً أن تعجز السلطة الحالية عن ضبط الأمن والأمان، مطلب الناس الأساسي، بسبب انفلات عناصر منتمين إلى أجهزتها كما تدّعي. الأسوأ من هذا أنّ الأمر نفسه قد يتكرّر لأيّ سببٍ سياسيٍّ أو عسكري لا دخل لنا به”. فيما يشرح الشاب، علي عيسى، من بلدة القرداحة وهو يعمل في قطاع التعليم كإداريّ قائلا: “هذه الأزمة الوجودية تدفع الكثيرين إلى البحث عن مكانٍ يمكنهم فيه إعادة تعريف هويتهم بعيداً عن سوريا التي لم تعد كما عرفوها، ولا كما حلموا بها”.
وهكذا أدّى التصاعد المتكرّر للتوتّرات الأمنية، وتهديدات النزوح الداخلي التي شهدت تزايداً كبيراً بعد مجازر السادس من آذار/ مارس وما تلاها ضمن مناطق مختلفة من الساحل السوري من استمرار ممارسات القتل والخطف، إضافة إلى غياب الجهات الأمنية الضامنة لأبسط حقوق الناس في التنقّل والعمل، إلى إعادة حلمٍ قديمٍ مؤلمٍ إلى الواجهة: الهجرة والسفر والخروج من البلد بأيّة وسيلة، وهذه المرّة من الساحل السوري الذي لم يتوقف نزيف أبنائه حتى الساعة. وهو ما تؤكّده الوقائع، حيث “انتشلت سلطات الإنقاذ في قبرص جثث سبعة أشخاص، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى الجزيرة، بعد أن انطلقوا على متن قارب من محافظة طرطوس يتوقع أنه كان يحمل على متنه 20 شخصاً” وفق تقرير نشرته القدس العربي. وليس بعيداً عن هذا الخبر، يتيح العبور أمام مبنى الهجرة والجوازات في اللاذقية أو طرطوس مشاهدة مئات الأفراد ممن ينتظرون دورهم للحصول على جواز سفر بتكلفةٍ ليست قليلة. هؤلاء المئات ليسوا أبناء طائفةٍ واحدة. إنهم سوريون يطرقون أبواب العالم من جديد بحثاً عن نجاةٍ يبدو احتمالها ضعيفاً هذه المرّة.
بعد سقوط النظام.. لا أمان، ومجازر، وانهيارٌ اقتصادي، وأفقٌ مجهول
اللاذقية، التي كانت تُعتبر آمنةً نسبياً، لم تعد كذلك. فمنذ مجازر الساحل في مطلع أذار/ مارس لم تتوقف الانتهاكات. في الأيام العشرة الأولى من شهر نيسان أبريل ٢٠٢٥، سقط ما لا يقل عن 26 شخصاً في سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في مقاهيها، التي كانت تعجّ بحديث الثورة والمستقبل، بات الحوار اليومي يدور حول كيفية مغادرة البلاد. يقول مشغّل أحد مقاهي منطقة الزراعة، قيس حاتم (أربعون عاماً): “المفارقة أنّ سقوط النظام، الذي كان يُفترض أن يُنهي أسباب الهجرة، زاد الطين بلّة. تحت أنقاض الحرب، برزت فجواتٌ جديدة تدفع الشباب إلى حزم حقائبهم: قلقٌ أمنيٌّ متجدّد مع كلّ تحركٍ لقوات الأمن أو الفصائل التي لا يضبطها شيء ولا قانون يردعها، يُضاف إليه قلقٌ يوميّ مع كلّ خبرٍ عن احتمال قصفٍ إسرائيليّ على مواقع عسكرية مثل موقع سقوبين الملاصق للّاذقية التي تضم عشرات آلاف السكان، وطائفيةٌ خفية ومعلنة تظهر في أبسط التفاعلات اليومية، واقتصادٌ منهار حوّل الشهادات الجامعية إلى مجرّد أوراق لا تساوي ثمن تأشيرة السفر”.
“كنا نظن أنّ التغيير سيأتي بالحرية، لكنه جاء بفوضى لا نعرف كيف نتعايش معها”، يعترف مهندسٌ شاب في الخامسة والعشرين من عمره يعمل في مرفأ اللاذقية (طلب عدم ذكر اسمه) كان من أشدّ المؤيدين للثورة، التقيناه في المقهى نفسه: “في مؤسسات الدولة هناك كآبةٌ واضحة في المعاملات والتعاملات اليومية. وهناك تخبّطٌ إداري كبير. مؤسساتٌ تدار بعقلية النهب”.
هذا التحوّل من “الهروب من النظام” إلى “الهروب من كل شيء” يفسّر لماذا صارت مقاهي الجامعات أشبه بوكالات سفرٍ غير رسمية، ولماذا تحوّلت أحاديث الأصدقاء من السياسة إلى مقارنة أسعار تأشيرات الدول. يقول المهندس “تمام” من قرية الشلفاطية التي شهدت مجازر طائفية إنّ “الساحل الذي وقف أهله مع التغيير في سوريا يجد نفسه اليوم أمام معضلةٍ وجودية، البقاء يعني العيش على هامش التاريخ، والمغادرة تعني الاعتراف بأن كل التضحيات ذهبت سدى”.
“نحن لسنا على خط نارٍ مباشر، لكننا نعيش احتمال اشتعال النيران كلّ يوم”. هذا ما تصفه الطالبة في كلية الطب سنة ثالثة، من مدينة بانياس لينا ابراهيم، مضيفةً: “على رغم أنّ الجامعات لم تتحوّل إلى ساحات قتال، إلا أنّ القصف الإسرائيلي المتكرّر على مواقع مثل المينة البيضا (شمال اللاذقية)، وتصاعد عمليات الاغتيال والاشتباكات في المناطق المحيطة (مثل جريمة دوار الأزهري وغيرها كل يوم)، أعادا تشكيل مفهوم (الأمان) في ذهن السوريين في الساحل السوري. الخوف من التصعيد المفاجئ صار كافياً لجعل فكرة الاستقرار مستحيلة”.
حتى لو تجاوز الطالب مخاطر العنف والتمييز، فإنّ السؤال الأكبر: ماذا بعد التخرّج؟ “حصلتُ على شهادة الصيدلة قبل عامين، وأعمل اليوم في مستودع أدويةٍ براتب لا يتجاوز مئة دولار شهرياً”، يقول كريم مغيروني (25 عاماً) من مدينة اللاذقية. ويتابع كريم: “العنف الطائفي، الفوضى الأمنية، والانهيار الاقتصادي حوّلت (النصر) إلى كابوسٍ يومي. هذه العوامل لم تدفع الشباب إلى حزم حقائبهم فحسب، بل حولت الهجرة من (خيار) إلى (ضرورة جماعية)”.
الهوية المفقودة… الساحل السوري غريبٌ عن أهله
في شوارع الساحل التي كانت تعجّ بحياة مختلفة قبل عدّة شهور، تسير خريجة الهندسة سارة فندي من جبلة (25 عاماً)، وهي لا تعمل الآن، تقبع في انتظار قرار تعيين في وظيفةٍ حكوميّة قد لا يأتي أبداً وإلى جوارها يمشي جيلٌ لا يحلم إلا في الهجرة. تقول سارة: “كل يوم يمرّ أشعر أن مدينتي تبتعد عني أكثر. الأماكن نفسها، لكن الروح تغيّرت”.
هذا التحوّل في الهوية الجماعية للساحل السوري أصبح دافعاً خفيّاً يُضاف إلى أسباب الهجرة. يشرح الشاب علي عيسى من بلدة القرداحة، وهو يعمل في قطاع التعليم كإداريّ: “الشباب الذين عاشوا سنوات الحرب يحملون ذكرياتٍ عن ساحل مختلف، منفتحٍ على العالم وعلى السوريين ككل، ليس كما كان في عهد الأسد، وليس كما صار بعده. إنهم يعانون من اغترابٍ مضاعف، عن الماضي الذي لم يعودوا يريدونه، وعن الحاضر الذي لم يختاروه. نحن لسنا ضحايا نظام فقط، بل ضحايا تحوّلٍ لم نكن نتخيّله”.
اليوم، هناك اكتشافٌ للهويات الطائفية لدى كثيرين من جيل الشباب. يقول “علي”: “لا أعرف ما هي الحصيلة التي ينالها من يسألك على الطالعة والنازلة عن طائفتك؟ ماذا تقدّم له هذه المعلومة؟ إذا جنّ ربعك عقلك ما ينفعك لذلك إذا كان فيك تغادر، ضب شناتيك ولا تقصر”.
“في الكلية، لم نكن نسأل بعضنا عن الطوائف”، تتذكر الطالبة في كلية الصيدلة من مدينة طرطوس رنا سليمان، وتتابع: “اليوم صار السؤال الأول الذي تواجهه عند التعارف هو السؤال الطائفيّ علناً أو خفيةً”. هذا التحوّل المفاجئ في الأولويات الاجتماعية يضع الشباب أمام معضلةٍ وجودية: كيف يحافظون على هويتهم المدنيّة في ظل تصاعد الخطاب الطائفي؟ “كنت أعتقد أنني سوريّةٌ أولاً”، تقول رنا، “لكن الأحداث الأخيرة أجبرتني على إعادة النظر حتى في طريقة كلامي”.
“الثورة كانت تعني الحرية، لكن (الحرية) التي جاءت بعد سقوط النظام صارت أكثر الأشياء التي نخاف منها”، تعترف رنا، وتتابع “ففي ظلّ انعدام القانون، صارت (الحرية) تعني حرية الميليشيات في التحرّك، وحرية الأقوى في فرض إرادته. هذه المفارقة تدفع الكثيرين إلى مفارقةٍ أخرى: الحنين إلى زمنٍ كان القمع فيه على الأقل منظّماً ومتوقعاً”.
هذه الطبقات المتعدّدة من الاغتراب تخلق شعوراً جماعياً بالتشظي. “كأننا نعيش في مدينةٍ شبحية، كلّ شيء فيها يذكرنا بما كان ولم يعد”، تصف “نورا” (22 عاماً) ابنة جبلة من الطائفة السنيّة وهي تعمل في محلّ تجميل. هناك انقسامٌ واضح في العلاقات الجماعية. وتتابع: “كلّ طائفة تعيش ضمن حدود حاراتها، وما إن يحل الليل حتى نعود إلى بيوتنا ونغلق الأبواب والشبابيك خوفاً من المجهول. هذه الأزمة الوجودية، الأعمق من كلّ المشكلات المادية، قد تكون الدافع الأقوى الذي يدفع أقدام الشباب نحو المجهول، إذ أنه من المحتمل أن يسألك فصيلٌ مسلح عن طائفتك وترتبك في الإجابة، أو لا تريد الإجابة، فيكون مصيرك بضع طلقاتٍ في الرأس. هذا ما حدث في جبلة عدّة مرات بعد مجازر السادس من آذار”.
بين أحلام الهجرة وإمكانية تطبيقها
تلعب تكلفة السفر والمكان المقصود دوراً كبيراً في حدّ كثيرين عن التفكير بالسفر. يقول المحامي علي غانم (في أواخر ثلاثينياته) من اللاذقية في حوارٍ معه إنّه جرّب التقديم على اللجوء الإنساني في البرازيل عبر موقعٍ الكتروني فاكتشف أنّ الشيء الوحيد المجانيّ هو الإقامة في البرازيل، في حين أن “تكلفة السفر والأوراق والإقامة الفندقية الحصرية جميعها عليه، وتبلغ في الحدّ الأدنى ثلاثة آلاف دولار تعادل راتب موظفٍ حكوميّ لمدة ستين شهراً، وهذا يعني الحاجة إلى بيع أصول مادية مثل البيوت والسيارات في حال توفرها ولكن سوق العقارات في أسوأ أحواله ومثله سوق السيارات التي تهاوت أسعارها كثيراً”.
يرى علي أنّ قلّةً قليلة من الناس يمكنها أن تغامر بالسفر إلى بلدٍ بعيد كالبرازيل من دون وجود احتمال عقد عمل وهذا يصح على فردٍ واحد فما بالك بأسرة؟ ويضيف: “عموم أهل الساحل فقراء ليس لديهم شيءٌ من هذا المبلغ في ظلّ فصل آلاف الموظفين من أعمالهم واختفاء آلاف الأعمال. في واقع الأمر، مَن أراد السفر من الأغنياء فعل ذلك قبل وقتٍ طويلٍ من سقوط النظام، هذه الحسابات المادية تخلق طبقةً جديدةً من المهمّشين: أولئك الذين يريدون الهجرة لكنهم محبوسون في وطنٍ لم يعودوا يعترفون به”.
هذه المعادلة القاسية تخلق فجوةً هائلة بين الرغبة في الهجرة والقدرة عليها. فبينما يزداد عدد الراغبين بالمغادرة يومياً، تتحوّل الهجرة إلى امتيازٍ طبقيّ. “الأسر التي تمتلك شبكة علاقاتٍ في الخارج، سواءٌ عبر مغتربين يرسلون الأموال أو معارف يسهلون الإجراءات، هي وحدها القادرة على عبور هذه الهوة. أما البقية، فيجدون أنفسهم محاصرين في دوامةٍ من الحلول المستحيلة” يقول علي متابعاً حديثه معنا.
البعض يحاول ركوب البحر من رأس البسيط إلى قبرص، رغم أنّ تكلفته تصل إلى ألفي دولار ومخاطره لا تُحصى. “أعرف عائلاتٍ باعت كل ما تملك لتمويل رحلةٍ واحدة لابنها، أما اللجوء إلى الهجرة الداخلية، أي إلى المدن السورية الأخرى فهو غير ممكن في الساحل السوري أساساً بسبب الحمولات الطائفية الكبيرة التي تتفجّر في البلد. في دمشق تعمل عائلاتٌ كثيرة من الساحل السوري على العودة إلى قراها ومدنها الساحلية حيث لا يتوفّر أيّ نوعٍ من الأعمال ولا الآمال. فعلياً، ومن دون أيّة مبالغة، في بعض القرى الساحلية، لم يبقَ سوى كبار السن والأطفال، وهؤلاء يشكلون لوحةً كئيبةً لمستقبل مجتمعٍ يفقد مقومات بقائه الأساسية يوماً بعد يوم” تقول منى حويجة، عاملة إغاثة من اللاذقية.
في المقابل، تظهر فئةٌ جديدة من “المحاصَرين”، أولئك الذين تمكنوا من جمع المال لكنهم عاجزون عن المغادرة بسبب تعقيدات الإجراءات أو نقص الوثائق أو مشاكل الفيزا. يقول طالبٌ في كلية الهندسة، كريم إبراهيم، من طرطوس: “تمتنع كثيرٌ من الدول اليوم عن منح السوريين فيزا نظامية للدخول بعد عشر سنوات من تدفق السوريين حول العالم. لقد حصلتُ على منحةٍ دراسية في الولايات المتحدة لكنني عالقٌ هنا منذ عامٍ تقريباً لأنّ الحكومة الأميركية لم تقرر حتى الآن منحي الفيزا”.
الأكثر إيلاماً أن هذه العقبات لا تُوقِف تدفق الراغبين بالهجرة، بل تدفعهم إلى خياراتٍ أكثر خطورة. أحاديث محلية تتحدّث عن ظهور “سماسرة هجرة” يقدمون عروضاً ووعوداً كاذبة بطرق غير شرعية سبق للسوريين أن جرّبوها في العديد من سنواتهم. “يبيعون الناس أوهاماً، وينتهي الأمر ببعضهم في السجون أو في قاع البحر”، كما يقول كريم.
هكذا، في ظلّ غياب أيّة حلول مؤسساتيةٍ من النظام الجديد في سوريا أو حتى طرحها، وغياب أيّة برامج دعم دولية، يصبح الساحل السوري سجناً مفتوحاً لمعظم أهله. الأغنياء غادروا، والفقراء يحلمون بالخلاص، والطبقة الوسطى تتآكل يومياً بين ارتفاع التكاليف وغياب أي أمل. السؤال لم يعد: لماذا تهاجر؟، بل كيف تفعل ذلك إن كنت من المحظوظين القلائل الذين يستطيعون؟
صحفي وكاتب سوري
حكاية ما انحكت
——————————
الأزمة الطائفية وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الأسد/ أحمد عيشة
2025.05.24
انتقل الصراع في سوريا، بعد الخلاص من بشار الأسد، إلى صيغة جديدة تتمحور حول طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم الاقتصادي والسياسي.
لم يخرج الصراع هذا عن الجذور العقائدية/الأيديولوجية للمشتغلين في الشأن العام من تيارات سياسية، أو شخصيات مستقلة ومثقفين، ناهيك عن الأصوات المعبرة عن الطوائف، التي برزت مؤخراً بمجالسها وشيوخها وطغت على المشهد برمته، معبّرة عن وجهات نظر كانت مدفونة وكان التعبير عنها ممنوعًا.
ورغم التوافق الظاهري حول شكل الدولة بأنها مدنية تقوم على حق المواطنة وتمثيل الجميع، إلا أن ذلك التوافق كشف عن رؤى تفتيتية للبلاد، ونموذج تمييزي من المواطنة. بكلمات عامة، كانت المطالب تتركز حول امتيازات لجماعات عانت من الظلم، ولأخرى كي لا تتعرض للظلم، مما يُخفي كثيراً من المواقف الطائفية خلف ادعاءات بمعارضة طائفية السلطات الجديدة، كونها انبثقت عن تنظيم سلفي جهادي، في حين كان الصوت الوطني الديمقراطي هو الأضعف إن لم يكن غائبًا.
فرضت فرنسا، في إطار رؤيتها الاستعمارية، شكل الكيان السوري بما يتعارض مع تطلعات سكانه، بهدف تقسيم البلاد لضمان السيطرة، من خلال دويلات تقوم على أسس طائفية. بعد الاستقلال، اندفع أبناء الأرياف والأقليات الذين عانوا من التهميش لفترات طويلة لللالتحاق بالجيش وأيضاً بالأحزاب، وخاصة ذات المنحى الاشتراكي، حيث تمكنوا بعد سنوات من الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب 1963، الذي سيطر فيه حزب البعث على الحكم بدعم من لجنة عسكرية سرية معظم أعضائها من الأقليات، من بينهم حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة عام 1970، بعد صراع داخلي في الحزب، أنهى مرحلة من حكم يساري الشكل، وأسس دولة أمنية مركزية، وضع فيها أقاربه ومعارفه من الطائفة في مواقع حساسة، ومنح بعض السنّة مناصب شكلية دون سلطة فعلية، فخلق سلطتين: الأولى ذات تركيبة طائفية في الجيش والمخابرات وهي الحاكم الفعلي، والثانية شكلية تشمل الجميع، وهي واجهات لا أكثر.
باختصار، تحوّل النظام إلى حكم طائفي بواجهات “وطنية”، ما جعل بنيته طائفية وشكله “وطنيًا”.
لمحاولة فهم ما حدث ويحدث في سوريا، من الضروري تحديد مستويات الصراعات في البلاد، وهي متنوعة وذات أبعاد طبقية، وريف-مدينة، وطائفية، لكن الطابع المهيمن في سلطة الأسد هو الطائفي، الذي تجلى بتركيبة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المعارضين والثوار بطريقة تمييزية (عنف معمم في مناطق ومخصص في أخرى)، حيث خلق التعامل الوحشي ردات فعل طائفية مقابلة وساهم في تأسيس تيارات ذات نزعة طائفية أيضاً. إن تفسير كل ما جرى ويجري في سوريا وفق البعد الطائفي فقط غير كافٍ؛ فهو يوفر تفسيرًا أحاديًا لظاهرة معقدة لها جذور تاريخية عميقة. لذلك، لا بد قبل محاولة التفسير من توضيح بعض المفاهيم: ما هي الطائفية، وما هو الدور المحوري الذي لعبته في الصراع؟ من المهم أيضًا معرفة التركيبة الديموغرافية في سوريا لما لها من دور في فهم الصراع ككل.
الطائفية حسب برهان غليون “نتاج لغياب الدولة الوطنية الحديثة وفشل مشروع المواطنة”، وحسب عزمي بشارة: “استخدام سياسي للهويات الدينية في صراع المصالح”، فهي فعل سياسي للسلطات أو القوى المتصارعة على السلطة قائم على التعصب والتمييز والمصالح، يركز على الاختلافات المتخيّلة بين الجماعات الدينية ويجعل منها أساساً لخندقة تقوم على “نحن” و”هم”، و”هي”. بمعنى ما، تسعى الطائفية إلى تحويل الاختلافات إلى أساس لصراع وجودي: إما نحن أو هم، وتلغي إمكانية التفاهم بين الطرفين، وتدعو إلى أشكال من التطهير أو الإبادة.
لم يكن الصراع الطائفي جديداً في سوريا، فهو يعود لبدايات تشكل الكيان السوري، لكنه أصبح محوريًا في فترة الأسدية التي اعتمدت في حكمها على القوة العارية للجيش والمخابرات ذوي الهيمنة الطائفية، التي حولت سوريا ذات التنوع في تركيبتها السكانية إلى مصدر للانفجار والاقتتال بدل أن تكون مصدراً للقوة من خلال الاعتماد على قاعدة طائفية من جهة وتشجيع العداوات المتخيلة بين تلك الجماعات من جهة أخرى، مع العلم أن تلك الجماعات السكانية، وبغض النظر عن النسب، ليست كتلة صماء، وإنما تتباين في المواقف والمصالح وتخضع لتناقضات داخلية وصراعات مثلها مثل أي جماعة أخرى، يتشابك فيها الديني مع السياسي مع الاقتصادي (المصالح).
خلقت هذه الهيمنة مظالم كبرى، زادت من تأجيج الصراع، خاصة بعد الثورة وما شهدته من فظائع ارتكبها النظام بحق السوريين، إلى درجة أن الطائفية أصبحت خط الصدع الوحيد الذي يتمتع بسلطة فعّالة على الجميع. ورثت الإدارة الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام بلداً مدمراً يعاني من الفقر والتهميش والانقسامات الطائفية. وهي انقسامات عميقة يتأثر بها الجميع، يبدو الخلاص منها حتى على مستوى الخطاب أمرًا يحتاج إلى سنوات طويلة. وهذا يتطلب من الجميع وخاصة من السلطة بناء خطاب وممارسة دقيقتين، يركزان على خلق التقارب والوحدة بين مختلف الجماعات الإثنية والدينية، فمستقبل سوريا يكمن في القدرة على بناء هذا الخطاب والسلوك، كما أن الفشل في ذلك قد يدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة.
مثلت أحداث آذار في الساحل، وما تلاها من تطورات في السويداء وبعض مناطق ريف دمشق (جرمانا وأشرفية صحنايا)، الاشتباك الأول للخطاب السياسي مع حالة الانقسامات تلك، حيث أخذ شكلاً انفجارياً يعكس عمق الأزمة الطائفية. فالخطاب الذي تقدمه تلك الجماعات حول شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي كان خطاباً أيديولوجياً يسعى لتعبئة طائفية، ومحاولة للحفاظ على امتيازات قديمة أو خلق أخرى جديدة، مع نزعات تفتيتية، فلم يكن حديثهم عن دولة المواطنة سوى قناع زائف لمطالب أخرى. ونتيجة ربط النظام للطائفة بوجوده، بغض النظر عمّا إذا كان جميع أفرادها موافقين أو مستفيدين، وفي ظل غياب صوت جماعي يرفض الفظائع التي ارتُكبت خلال الثورة (رغم وجود أصوات فردية معارضة)، وجد العلويون أنفسهم محاصرين بين مطرقة الانتقام وسندان النظام، وضحايا لتلك السياسة.
يتفق معظم السوريين، في الخطاب، على قيام دولة قانون تحقق الكرامة والحرية، لكن تظهر التناقضات والصراعات حول مضمون هذه الدولة وطريقة تحقيقها، ما يكشف عن عمق الجذور الطائفية التي تغلف الممارسة السياسية والمصالح الضيقة وتفقدها مصداقيتها. ومن جانب آخر، يظهر ضعف بنية الجماعات السياسية. كان غياب صوت العقل والنقد الموضوعي هو السائد، باستثناء بعض الأصوات الفردية، حيث غابت السياسة بمعناها الحقيقي كصراع وتسويات بين قوى اجتماعية، وتحولت إلى اشتراطات وطلبات واجبة التنفيذ.
أمام هذه التركيبة والصدوع العميقة، يبقى المخرج الوحيد هو العمل على بناء دولة من خلال تأسيس جيش وقوات أمن على أسس وطنية مهنية، تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري. دولة تعمل على بناء هوية وطنية سورية تقوم على المواطنة التي تساوي بين الجميع، وتخلص البلاد من منطق الأكثرية والأقلية القائم، دون تمييز لجماعة على أخرى تحت ذريعة حماية الأقليات كما يطالب البعض في الداخل والخارج، وتقوم على نظام يعتمد التنوع السياسي أولاً، الذي يضمن سلامة التنوع الثقافي والاجتماعي لا العكس، ويكفل مشاركة عادلة للجميع، وأولى تلك الخطواب بناء جيش وقوات أمن على أسس وطنية، وهو انجاز هائل إن تمكنت الحكومة الجديدة من تحقيقه، إضافة للتخلص من المناهج التعليمية المتعددة ذات الصبغة الأيديولوجية، والاهتمام بمسألة العدالة الانتقالية من خلال محاسبة رمزية أو فعلية على الجرائم والانتهاكات.
ويبقى في النهاية القول إن فهم الأزمة السورية من منظور طائفي فقط هو فهم تبسيطي، يتجاهل تعقيدات أخرى مثل: الصراعات الاجتماعية البينية، والقوى الخارجية ونزعات الهيمنة لديها، والنظم السلطوية. فالطائفية ليست سوى واحدة من أدوات التدمير لدى القوى المهيمنة، كما أن الخلاص منها هو عملية سياسية بامتياز، طويلة الأمد، تبقي على التنوع في إطار الوحدة، فمصدر قوة البلدان اليوم تنوعها، ومستوى الحرية فيها.
تلفزيون سوريا
——————————–
السوريون وقميصُ عثمان المُدمّى
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
انطلاقاً من ضرورةِ ضبط إيقاع المخاض النهضوي العسير في المرحلة الانتقالية، شهدت سورية تغييرات سريعة منذ فرار بشّار الأسد، أهمها قرار رفع العقوبات الغربية الذي أعلنه دونالد ترامب في كلمةٍ له في الرياض، ليُعتبر الهدية الثمينة الثانية بعد إسقاط نظام الأسد، ويشكّل منعطفاً حاسماً في مسار الدولة والمجتمع يُعيد رسم علاقة سورية بالعالم من حولها، خصوصاً وأنّ الرئيس الأميركي أخبر أحمد الشرع أنّ لديه فرصة نادرة لقيامةٍ عظيمة في بلاده بعد منح شعبه بداية جديدة. وأقول: السوريون، بدورهم، يملكون فرصة تاريخية لن تتكرر لرفع ما هو ألعن وأكثر خطورة، وأقصد بالطبع القيود الطائفية.
في المقابل، شكّل القرار تطوراً دراماتيكياً هاماً فتحَ الباب أمام تساؤلاتٍ ملتهبة بشأن جدوى هذا التحوّل المفاجئ بالتوازي مع إرث النظام المخلوع وتداعياته على بلد خرج لتوّه من الجحيم، وعلى جنباته المُقفرة تنفجر الأحقاد المعلّقة، تحت مشاهد مذابح طائفية، أو صدامات ومظاهرات طائفية، بما يوحي وكأنّ سورية دخلت حقبة أبدية، لكن بسياقٍ آخر.
من هنا، من الدقّة بمكان الإشارة إلى أنّ ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة. ويبقى السؤال الملحّ أنه ووسط الفراغ الأمني الهائل القائم على الاستقطاب المذهبي والعرقي، كيف سيكون السوريون جديرين بكرم ترامب غير المسبوق؟ يرتكز الجواب على حفنةِ تفاؤل، خصوصاً وأنّ المُعطيات المتوفّرة، حالياً على الأقل، تؤكد أنّ الطائفية لن تكون المشكـلة التي ستعاني منها سورية المستقبلية اللامركزية، وهي تسير قدماً باتجاه “الفدرلة”، إنْ جرى تقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات حسبما أعلن عنه وزير الداخلية السوري في الآونة الأخيرة.
ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة
بالتساوق مع ما تقدّمـ يقع على عاتق السلطة الحالية مسؤولية خلق وعي سياسي ووطني ضمن فضاءات مدنية واسعة، لردع الخطابات الديماغوجية الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك المهرجانات الدعوية الكاريكاتورية والتجاوزات المستفزّة، التي لم تكن مجرّد تصرّفاتٍ خرقاء فردية من متديّنين متشددين ومتحمّسين، إذ كشف زخمها مستويات عالية لخطاب الكراهية والإقصاء، أيضاً تسويق مصطلحَي الأغلبية “المُباركة” والأقلية “المُدانة”، ما يمثّل عصياناً يمهد لحالة انقلابية على الهوية الوطنية الجامعة، وإشاعة حالة عدم يقين في وقتٍ تحتاج البلاد فيه إلى رأب التصدعات وهدم الجدران العازلة التي خلّفها النظام البائد، الذي روّج كذبة كبيرة أنه “حامي” الأقليات. لنتذكّر: عند تأسيس الجيش السوري عام 1945، نُقلت إليه كلّ مقدرات جيش الشرق البشرية، ومنها العلويون، الذين وجدوا أنفسهم بين الآباء المؤسسين للمؤسسة العسكرية، ولم يكونوا منبوذين ومضطهدين، كما ادّعى حافظ الأسد. وعلى السوريين اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، دحض تلك الأكاذيب، واستنكار المصطلحات المتداولة عن سُنّة أكثرية في دولة أموية يُعاد إنعاشها قسراً، بصفتها انحرافاً كارثياً عن طريق بناء بلد عابر للطوائف والأعراق.
فعلياً، لا توجد حساسية طائفية إلاّ عند من يتبنّاها ويسوّقها، بالتالي فإنّ التضخيم المغرض للسرديات الطائفية وارتفاع الأصوات المحرّضة، هدفه تسهيل الطريق لتمزيق النسيج الاجتماعي، بداية في الساحل السوري، ولاحقاً في البيئة الدرزية بعد التسجيل الصوتي المفبرك وتداعياته الكارثية، وعلى الطرف الآخر ترتفع نسبة شيطنة “الأكثرية” من قبل “أيتام الأسد”، وشيطنة “الأقليات” من قبل المتطرفين الحاقدين، إضافة إلى باقي الطوائف والإثنيات، خصوصاً الكردية التي لا تخفي مخاوفها الوجودية من المستقبل…إلخ، هذه الدوامة الطاحنة لم تُوقع السوريين في الفـخّ الطائفي المُحكم، بدلالة أنه وفي الوقت الذي تظهر به أصوات تتناول مجريات الأحداث المشتعلة بأبعاد طائفية وبلغة عنصرية مقيتة لا تخدم إقامة السلم الأهلي، تظهر أصوات مقابلة تُدين هذا “الزعيق الطائفي” وتسخّفه في مكان. وخير دليل على ذلك ملصقاتٌ عُلّقت في اللاذقية تدعو إلى تكفير العلويين، ليزيلها عقلاء من السنّة على الفور.
وعليه، التذكير بأسباب الطائفية ليس مجرّد اجترار مجاني للماضي وإنما إنعاش للوعي المغيّب بما يجب أنّ يُعلَمَ بالضرورة، ومن ثمّ، فإنّ استحضار أحداث حماة (1982)، مثلاً، والتي فعّلت نبرة الطائفية إلى الحدود القصوى بعدما كانت في مستواها الأول غير الملموس، مدخلٌ لازم للبحث في سُبل الشفاء من اللعنة السوداء التي فُرضت على السوريين وأصبحت ملازمة لهم، بعدما دفعهم نظام الأسد للتمسك بهوية إيمانية دوغمائية تضع الذات في مفارقة جدلية عقيمة مع الآخر المختلف لفرض حالة تضاد صدامي صالحة دائماً للاستثمار، ما يجعل اللوحة الفسيفسائية السورية المصطلح الأكثر ابتذالاً الذي عرفه السوريون يوماً.
نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم
بطبيعة الحال، يُجمع مراقبون على أنّ الطائفية بمزاجها المتشدّد دخيلةٌ على المجتمع السوري المتسامح نسبياً، ولا شك مرّت نزعة “الشِقَاق الوطني” بمحطات هبوط وصعود بلغت مداها في عهد نظام الأسد، الذي رعاها ضمناً وأنكرها علناً، معيداً ترتيب مفردات الاختلاف الطبيعي بين المكونات السورية لتخديم سلطته العميقة وتكوين آلته القمعية. وحين رُفع غطاء الجحيم عن البلاد أخيراً بإعلان نهاية حكم الأبد إلى غير رجعة ظهرت أمراضٌ مجتمعية ساهم في صناعتها، وهي، في جوهرها، ليست إلاّ سجال الألم وسعار الغضب اللذين ينتهيان دائماً إلى عباراتٍ سامّة، من قبيل “نحن” و”هم”. واليوم، وفي لحظة مفصلية حرجة تشهدها سورية والمنطقة، المتاح إما مصالحة وطنية تُنهي تراشق التهم الطائفية بين الأطراف المختلفة أو أن تغدو التحالفات والأيديولوجيات سبيلاً لتثبيت مشروع “أفغنة” الدولة، وهي أفضل السيناريوهات الممكنة حينها، أو لمشروع احترابٍ دموي دائم في أسوئها.
يتوجب الجزم بيقين أنّ المشكلة الطائفية لم تنشأ بسبب التنوّع وتناقض مصالح الطوائف، بل تكمن أساساً في الاستثمار السياسي فيها، ولا يمكن اجتثاثها من جذورها إلا بترسيخ أسس الديمقراطية الفعلية، بعيداً عن منطق المحاصصة. والواقع أنّ ضرب الخطاب الطائفي لن يتمّ إلا مع سقوط الحاضن الأول له، وأقصد تركة الأسد، على القدر نفسه من الأهمية، بوقوف السوريين جميعهم بحزمٍ ضد التخوين والعنصرية، خاصة تحريض سوريّي الخارج وقراءتهم مسبَقة الصنع للمشهد السوري، والذين انتقلوا بسرعةٍ مريبة من الانتقاد إلى مدافعين شرسين عن الحكومة الجديدة، لإيمانهم أنَّ “القوة دائماً على حقّ”. ولا نبالغ إذ نقول إنه ينطبق على الطائفية السورية توصيف “قميص عثمان المُدمّى”، الذي رفعه بنو أمية والنيّة المُضمرة لم تكن الثأر لعثمان، بل الوصول إلى نيل السلطان، واليوم تشهد الفضاءات السورية العامة ارتفاعاً مهولاً وممنهجاً في الخط البياني لخطاب العدالة “الانتقامية” بقصد الهيمنة والتمكين، ما يؤكد على رُدّة وطنية للوافدين من أماكن التطرّف، وربما القهر، وبذريعة الشعار الأكثر استبداداً “من يحرّر يقرّر”.
نافل القول: تراجع الأزمة السياسية سينجم عنه بالضرورة تراجع في التوتر الطائفي، أما التعامل معه، بوصفه تحصيل حاصل لما تقدّم ذكره، فضرورة ملحّة لا تستوجب الإنكار أو التأجيل، باعتباره آفة مارقة تجعل التسليم بزواله نتيجةً لا جدال حولها. بالتالي، نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم، لمواجهة خطر هذا الطاعون القاتل، ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، لأنه، ببساطة شديدة، مصدرُ تفرّق وعداوة ضدّ التنوع والاختلاف، وأيضاً ضدّ الحياة.
العربي الجديد
———————–
=========================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 25 ايار 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
——————————-
اختبارات الهوية الوطنية: السويداء مثالاً/ جمال الشوفي
2025.05.25
لم يكن يتخيل أحد من أبناء السويداء من رواد ساحات الكرامة أنهم اليوم مطالبون بإثبات هويتهم الوطنية السورية! ساحة الكرامة التي مثلت ملتقىً وطنياً لكل شرائح المجتمع من شباب وشابات، رجال دين وسيدات، سياسيون معارضون وفرق عمل مدنية.. ومطالبهم كانت مطالب السوريين العامة في الحرية والكرامة والعيش الكريم في دولة المواطنة، مسترجعة ذاكرة السوريين في بدايات ثورتهم، حتى باتت عنواناً وطنياً يمتد على مساحة وطن استمرت لما يزيد عن عام وأربعة أشهر حتى سقوط نظام الأسد صباح الثامن من ديسمبر 2024، لتتحول بعدها لملتقى وطني سوري عام يزورها غالبية السوريين فرحاً واحتفالاً.
اليوم وبعد قرابة ستة أشهر من دخول سوريا في عصرها الجديد، عصر ما بعد الأسد ونظامه الأمني العسكري ودكتاتوريته الأيديولوجية الشمولية، النظام الذي أجهز على غالبية مقومات الشعب السوري مادياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، تواجه سوريا تحديات وصعوبات جمة. فإن كان أبرزها التحديات الاقتصادية والتي باتت على وشك الحل بعد رفع العقوبات الأوروبية والأميركية، وتوازيها التحديات الأمنية وضبط السلاح الفصائلي العشوائي وانخراطها في بنيان الدولة في وزارتي الدفاع والأمن. وليس فقط تبرز معها إشكالية الهوية والانتماء وسياقات التجييش الطائفي المعمم والذي يصر أطرافه إما على تكفير وإلصاق تهمة الخيانة للسويداء عامة ليقابلها وصم الإسلام السني عامة بالتطرف والإرهاب، وهذه مؤشرات خطر على النسيج والهوية الوطنية.
سنوات ما بعد العام 2018 وإفراغ الداخل السوري وتهجير سكانه ودمار معظم مدنه، اتسمت المسألة السورية بالاستنقاع السياسي. هذا الاستنقاع الطويل انعكس على المجتمع السوري بشكل كارثي طال السوريين في مستويات عدة يمكن إيجازها على سبيل الدلالة لا الحصر:
التباعد العام بين مكونات الشعب السوري وازدياد حدة المظلوميات من كل الأصناف، وكل فريق يرى في مظلوميته المظلومية القصوى.
تزايد حدة التقوقع الإثني والطائفي والديني وتنامي ظواهر التعصب والأيديولوجيات المرافقة.
تحاجز سياسي وفرط نمو في المكونات السياسية السورية وغالبيتها تدعي أحقية التمثيل السياسي العام وفقط.
تراجع حاد في قيم الألفة والانتماء وتنامي الفردانية على حساب القيم العامة، مترافق مع الجوع والحاجة التي عانى منها عموم الشعب السوري.
تراجع أصوات العقلانية السورية وبهتان إنارتها مع طفو المساحات المظلمة للمشاريع السياسية الانتفاعية من جراء الكارثة السورية، حتى بات المثقف السوري يشعر بغربة مضاعفة ويزداد انزواءً، فإن كتب قلما يُقرأ له والقول المتردد “شبعنا تنظيراً”.
بقيت النقاط أعلاه مؤشرات غير قابلة للتعميم استوجبت الدراسة والتحليل وإعادة التقييم في الأسباب وطرق الحل الممكنة. لكنها عادت اليوم للطفو من جديد. لتظهر في السويداء مقولات انفصالية تكرر دعواها بالإدارة الذاتية أو حلم الدولة الدرزية المشبوهة، وهذه المجموعة من الأفراد لا تمثل سوى نفسها وهي ليست كل أبناء السويداء. بالمقابل تظهر أصوات سورية تنادي بضرورة حكم السنة بعد تهميشهم وطول عذاباتهم التاريخية، مترافقة مع تجييش أعمى لقلة متطرفة تنادي بإبادة دروز السويداء وإخضاع جميع الأقليات بالقوة، وهؤلاء هم ليسوا كل أبناء أمة السنة السورية الموصوفة بالاعتدال والوسطية والانفتاح.
هذه المشاهد تجلت بوضوح في مسألتي طلاب السويداء في الجامعات السورية وما تعرضوا له من ترهيب نفسي معزز بالفعل المادي من بعض الخارجين عن القيم الوطنية السورية، حين حاولوا الاعتداء على الطلاب في الجامعات. ترافقها الاعتداءات شبه المستمرة واليومية من عصابات مجهولة وخارجة عن القانون على القرى الغربية من السويداء بعد أحداث جرمانا والأشرفية والصورة الكبرى بداية الشهر الحالي، الأمر الذي أدى إلى تزايد الأصوات التي تتهم كل السنة بالتطرف والإرهاب وضرورة القطع الكلي مع الدولة السورية والاستقواء بالخارج والمشاريع الانفصالية.
يمكن لأي محلل أيديولوجي أن يذهب مع إحدى الروايتين تأكيداً ودمغاً: رواية أن الدروز انفصاليون وقد خانوا الثورة، أو رواية أن السلطة الحاكمة في دمشق متطرفة إرهابية. وكلا الروايتين تجانب الحقيقة وتدخل سوريا والسوريين في مأزق وطني كارثي عنوانه الأبرز العنف وعودة ثقافة العصبة القبلية ما قبل الدولة. وهذه فرضيات جزافية تتجاهل غالبية أبناء السويداء وتاريخها الوطني وحضورها السياسي والمدني اليوم وهم يستنكرون الدعوات الانفصالية ويؤكدون على الانضواء في مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية وتفعيل ضابطتها العدلية والشرطية، متمثلاً بموقف فصائل السويداء الثورية التي عملت على الانضمام لوزارة الداخلية وأعلنت دعمها للشرطة في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط الأمن والأمان فيها. ونجد أيضاً أن الغالبية السورية العامة سواء من شرائحها السورية العامة أو ممثلي الحكومة السورية متمثلة بمحافظ السويداء ووزيري التعليم العالي والداخلية وهم يستنكرون الاعتداءات المتكررة على السويداء ويعملون على ردعها وإيقافها.
وبالضرورة يمكن أن نستنج منطقياً أن وجود قلة خارجة عن القانون في السويداء يقابلها قلة متشددة في الوسط السوري السني العام لا تمثل النسيج الوطني السوري، وتسعى لمصالحها الخاصة والذاتية محمولة على أيديولوجيا قاصرة تكفيرية مغلقة على نفسها ولم ترتقِ بعد لمصاف العصر والثقافة والحضارة. وليس فقط تسعى لتأجيج أي حدث راهن وتأليب الرأي العام مع أو ضد في ثنائية هدامة تبتغي العنف إراقة الدماء. وهذا مرض عضال وجب علاجه.
قد يقول قائل من حق السنة أن يحكموا سوريا بعد عقود من الاضطهاد والتنكيل، ويجيبه آخر من حق الدروز تقرير مصيرهم والدفاع عن أرضهم، وكلا المقولتين قاصرتين وطنياً وبنيوياً. فالحكم شراكة وطنية عمومية تستند لمنظومة دستورية وقانونية وتستبعد فكرة الغلبة والكثرة العامة والهيمنة المطلقة سواء سورياً أو مناطقياً، وهي مؤشر على استمرار ثقافة الدكتاتورية والشمولية السابقة سواء سورياً أو مناطقياً أيضاً. وبالضرورة يتطلب من الوطنية السورية متمثلة بشرائحها الثقافية والفكرية والسياسية والمدنية والنخبة السياسية القائمة في الحكومة الانتقالية السورية الحالية العمل على:
العمل الجاد على إيجاد أفضل الطرق لبسط الدولة ومؤسساتها على كل الأرض السورية، والوصول لتحقيق القانون ومحاسبة الخارجين عنه أفراداً ومجموعات سواء من داخل السويداء أو خارجها.
تحديد المسؤولية القانونية والثقافية عن خطابات الكراهية والتحريض الطائفي والعمل على محاسبة مروجيها.
الإسراع بتحقيق ملفات العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري قانونياً وقضائياً.
فتح الحوار الوطني الواسع حول القضايا الخلافية سورياً سواء السياسية الراهنة كالإعلان الدستوري وطبيعة الحكم والحكومة الانتقالية أو الثقافية العامة حول حق الإيمان والتدين والحقوق الفردية الفكرية والسياسية واحترام أصحابها وصون القانون لها.
فتح بوابات حوار الأديان وتحقيق الأرضية الثقافية العامة بقبول الاختلاف والتنوع السوري دون محاباة أو مغالاة.
جوهر المسألة السورية كان ومازال، دولة المواطنة، دولة الحق والقانون، دولة لا فرق فيها بين عربي أو كردي، سني أو درزي أو علوي أو مسيحي، فجميعهم متساوون بالحقوق والواجبات والحريات. وهو ذات الجوهر التي انطلقت منه الثورة عام 2011 وتابعته نضالات السوريين عامة ومنها ساحة الكرامة بالسويداء. فسوريا “بلاد الشمس”، كما كانت تعرف تاريخياً، ومركز إنارة وحياة لأبنائها ومحيطها العام، وتنبعث اليوم من تحت الرماد من جديد، وعليها الاستقواء بحكمة عقلائها وخبراتهم وقيمهم، حين يجتمعون في مركب واحد عنوانه المصلحة العامة والقيم المجتمعية والإنارة الفكرية التحررية. تلك التي قالت عنها قبل قرون حضارة اليونان بأنها الشأن العام “Res-politica” في ثلاثية متكاملة هي الدولة. فهل يمكننا تغليب لغة العقل والحوار على لغة العنف والكراهية، لغة ثقافة الدولة والبنيان على لغة الهدم والتقوقع العصبوي، لغة الاختلاف والنقد البناء الواضح على الخلاف والتباين الحاد والتنافس الهدام على المكاسب على حساب الدولة والثورة.
اليوم جميعنا في اختبار حقيقي عنوانه الهوية الوطنية وكلنا مسؤول عن وصولها لبر الأمان، فهل من مجيب؟
————————————-
حادثة محافظ السويداء.. السلطة والمجتمع ودور الإعلام في عصر “الترند”/ أغيد حجازي
24 مايو 2025
تحولت الحادثة التي تعرض لها محافظ السويداء، مصطفى البكور، إلى “قضية رأي عام”. وبين تضارب الروايات وغياب بيانات رسمية سريعة، وجدت الشائعات طريقها إلى الفضاء الرقمي، مهددةً بإحداث فتنة جديدة في بيئة تعيش واقعًا متوترًا وعلاقة معقدة مع السلطة الجديدة.
ما الذي جرى فعلًا داخل مبنى محافظة السويداء؟ هل هو عمل فردي بحت، أم ثمة تداخل مع المشهد السياسي الذي تتسيده الفصائل المسلحة؟ وما صدى الحادثة في مجتمع السويداء، وخاصة لدى الوجهاء والنشطاء السياسيين والاجتماعيين؟ وأخيرًا: أي دور لعبته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي صارت فاعلًا أساسياً في وقائع مثل هذه؟
الرواية الرسمية وإجراءات الاحتواء
يقول مدير مديرية الإعلام في محافظة السويداء، مرهف الشاعر، لـ”الترا سوريا”، إن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى المحافظة، مطالبةً بالإفراج عن موقوف لدى إدارة الأمن العام بدمشق منذ أكثر من شهر بتهم تشمل سرقة سيارة وجرائم أخرى.
وأوضح الشاعر أن أفراد المجموعة “أطلقوا تهديدات وألفاظًا نابية”، ملوحين بمنع المحافظ من السفر إلى دمشق ما لم يطلق سراح الموقوف. وأشار إلى أن الحادث وقع صباحًا، فتدخلت فورًا مجموعات الحماية، فيما “تعامل المحافظ بهدوء مع أحد المتحدثين بفظاظة”. وأضاف أن التنسيق مع دمشق أسفر عن حل الخلاف واحتواء الموقف، ليتابع البكور عمله ويستقبل وفودًا زائرةً في مبنى المحافظة.
وأكد الشاعر أن أبناء السويداء، بمختلف مرجعياتهم المدنية والسياسية والاجتماعية، استنكروا الحادث على نطاق واسع، وصدرت بيانات تدعو إلى ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار ودعم الضابطة العدلية.
وبيّن أن المكتب التنفيذي، بالتعاون مع قيادة الشرطة والفصائل المحلية، أصدر مذكرات بحث عن المشاركين في الاقتحام، بينما أعلن أهالي بلدة “ذبين” بريف السويداء الجنوبي “تبرؤهم من هؤلاء الأشخاص”، واصفين ما جرى بأنه تصرف فردي لا يمثل المجتمع.
وحول الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجهيز قوات من الأمن العام ووزارة الدفاع لدخول السويداء، ذكّر الشاعر بالاتفاق الموقع بين الإدارة في دمشق ووجهاء وشيوخ عقل السويداء والفصائل المحلية، والذي ينص على تفعيل دور قوى الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، ودمج عناصر من الفصائل في سلك الشرطة، مؤكدًا أن أكثر من مئتي شرطي التحقوا بهذه القوى منذ الأول من أيار/مايو 2025.
ونفى الشاعر صحة ما تروجه بعض الصفحات عن اختطاف المحافظ أو تعرضه للضرب، مؤكدًا أن خطاب الكراهية والفتنة لا مكان له بين مكونات المجتمع السوري.
وختم متوقعًا أن تؤدي الحادثة، التي جرت السيطرة عليها بأقل الخسائر، إلى فتح مسار جديد لتعزيز السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن قوى محلية، مثل حركة “رجال الكرامة” وتجمع “أحرار جبل العرب” ومضافة الكرامة، نزلت على الأرض دعمًا لموقف الشرطة وقوى الأمن الداخلي.
احتجاج محدود وتضخيم إعلامي
يقول رفعت الديك، صحفي من محافظة السويداء، إن ما حدث هو قدوم مجموعة من الخارجين عن القانون، يوجد لديهم أقارب مسجونون في دمشق وصدرت بحقهم مذكرات توقيف وأحكام بالسجن، إلى مكتب المحافظ، مطالبين بالنظر في قضايا المسجونين وإطلاق سراحهم أو إخلاء سبيلهم. وقد وعدهم المحافظ بمتابعة الموضوع وتسليمهم نتائج المتابعة في أقرب وقت.
يتابع الديك، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أنه بعد انتهاء الدوام، أقدم هؤلاء الأشخاص على اقتحام مبنى المحافظة بطريقة غير مألوفة؛ إذ لم يكن هجومًا مسلحًا بالمعنى التقليدي (دوشكا أو أسلحة ثقيلة)، بل اندفعوا بأسلوب فوضوي، واصطدموا بحرس المبنى، وهم من أبناء المحافظة العاملين في جهاز الأمن العام. حاول المحافظ استيعاب الموقف فأذن لهم بالدخول إلى مكتبه، لكن النقاش داخل المكتب احتد وارتفعت الأصوات وتخللته إساءات لفظية.
وأشار الديك إلى تدخل وجهاء مدينة السويداء الذين قدموا اعتذارًا رسميًا عن هذا السلوك، مؤكدين أنه تصرف فردي لا يمثل أخلاق أهالي المحافظة وأدبياتهم. وأكد الديك أن المحافظ استكمل عمله ثم غادر لاحقًا إلى دمشق لتوضيح الصورة واتخاذ ما يراه مناسبًا، بعد أن تم احتواء الحادثة بالكامل.
ويقول الديك إن المستغرب هو الطريقة التي انتشر بها الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ صور الأمر وكأن جميع أهالي السويداء، بما في ذلك الضيوف، هاجموا مبنى المحافظة، واحتجزوا المسؤولين وأجبروهم على قرارات بعينها، معتبرًا أن ما جرى ليس سوى مجرد فعل احتجاجي محدود قام به أفراد محتقنون بسبب تأخر تنفيذ وعد قطعه المحافظ؛ وهي حوادث تحصل في محافظات أخرى ولا تعد غريبة على المشهد السوري عمومًا.
ويتساءل الصحفي: لماذا يتم تضخيم أي حادثة تقع في بيئات الأقليات عبر حملات “ذباب إلكتروني” منظمة، بينما تُهمش الإضاءات الإيجابية، مثل زيارات المحافظ الميدانية ولقاءاته الودية مع وجهاء المدينة؟ ثم لماذا لا يُحشد الرأي العام بالقدر ذاته تجاه قضايا إنسانية كبرى، كجريمة قتل طفلة عثر عليها وقد سُرقت أعضاؤها؟
ويتحدث رفعت الديك عن حملات ممنهجة توظف أصغر الوقائع في السويداء لإثارة النعرات الطائفية وتشويه صورة أبنائها، في حين تمر ممارسات أشد خطورة ترتكبها فصائل منفلتة في محافظات أخرى من دون ضجة تذكر. ويقول: “إذا كنا نسعى حقًا إلى بناء وطن، فإن الطريق يبدأ بالمصارحة والمصالحة، لا بالتجييش الطائفي”.
ويخلص إلى القول: “الحدث فردي محدود لا يرقى إلى مستوى التعبئة الإعلامية التي رافقته، أما حملات التضخيم فهي جزء من مخطط منظم للإساءة إلى مكون اجتماعي بعينه وتشويه صورته الوطنية”.
رفض للحادثة ودعوة لتعزيز الأمن الداخلي
تؤكد الناشطة السورية وابنة مدينة السويداء، حنين القنطار، أن ما جرى داخل مبنى المحافظة “تصرف مدان ومرفوض قطعًا”، معتبرةً أنه لا يمت بصلة إلى منظومة القيم والأعراف الاجتماعية التي تربى عليها أبناء المحافظة.
وأشارت إلى أن تأثير الحادثة تجاوز الإساءة لشخص المحافظ ليطال كرامة المجتمع بأسره، معتبرةً أن الواقعة أضرت بصورة محافظة عرفت بالحكمة والرزانة.
وانتقدت القنطار ما وصفته بـ”تهويل إعلامي” مارسته بعض القنوات والمنصات، موضحةً أن هذه الجهات حرفت الوقائع بما يخدم مصالحها، بعيدًا عن المهنية والموضوعية.
ولفتت إلى أن أبناء السويداء لمسوا، منذ تسلم الدكتور مصطفى البكور مهامه، تفانيًا في العمل وسعة صدر وأسلوبًا راقيًا في التواصل، الأمر الذي أكسبه احترامًا واسعًا.
وختمت القنطار بالدعوة إلى “ضرورة الإسراع في تفعيل دور قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية للحفاظ على هيبة المؤسسات، وصون كرامة المواطن، وفرض سيادة القانون بعدالة وحزم”.
وتبقى الأسئلة التي تثيرها حادثة السويداء مشرعة، أولها بالطبع هو عن العلاقة الشائكة وغير المستقرة بين السلطة الجديدة وبعض فئات المجتمع السوري، والسؤال الذي لا يقل أهمية هو عن دور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. فأي رواية ستترسخ في الذاكرة الجمعية، رواية الاقتحام العابر أم رواية “الاختطاف” التي تصدرت العناوين الافتراضية؟
في ضوء اتساع الفجوة بين الخبر العاجل والحقيقة الميدانية، يجب أن يثار نقاش معمق حول مسؤولية المنصات الإعلامية في التحقق قبل النشر، وما إذا كان التحريض مقصودًا أم هو فقط من أجل “الترند”؟
الترا سوريا
———————————————
السوريون وقميصُ عثمان المُدمّى
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
انطلاقاً من ضرورةِ ضبط إيقاع المخاض النهضوي العسير في المرحلة الانتقالية، شهدت سورية تغييرات سريعة منذ فرار بشّار الأسد، أهمها قرار رفع العقوبات الغربية الذي أعلنه دونالد ترامب في كلمةٍ له في الرياض، ليُعتبر الهدية الثمينة الثانية بعد إسقاط نظام الأسد، ويشكّل منعطفاً حاسماً في مسار الدولة والمجتمع يُعيد رسم علاقة سورية بالعالم من حولها، خصوصاً وأنّ الرئيس الأميركي أخبر أحمد الشرع أنّ لديه فرصة نادرة لقيامةٍ عظيمة في بلاده بعد منح شعبه بداية جديدة. وأقول: السوريون، بدورهم، يملكون فرصة تاريخية لن تتكرر لرفع ما هو ألعن وأكثر خطورة، وأقصد بالطبع القيود الطائفية.
في المقابل، شكّل القرار تطوراً دراماتيكياً هاماً فتحَ الباب أمام تساؤلاتٍ ملتهبة بشأن جدوى هذا التحوّل المفاجئ بالتوازي مع إرث النظام المخلوع وتداعياته على بلد خرج لتوّه من الجحيم، وعلى جنباته المُقفرة تنفجر الأحقاد المعلّقة، تحت مشاهد مذابح طائفية، أو صدامات ومظاهرات طائفية، بما يوحي وكأنّ سورية دخلت حقبة أبدية، لكن بسياقٍ آخر.
من هنا، من الدقّة بمكان الإشارة إلى أنّ ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة. ويبقى السؤال الملحّ أنه ووسط الفراغ الأمني الهائل القائم على الاستقطاب المذهبي والعرقي، كيف سيكون السوريون جديرين بكرم ترامب غير المسبوق؟ يرتكز الجواب على حفنةِ تفاؤل، خصوصاً وأنّ المُعطيات المتوفّرة، حالياً على الأقل، تؤكد أنّ الطائفية لن تكون المشكـلة التي ستعاني منها سورية المستقبلية اللامركزية، وهي تسير قدماً باتجاه “الفدرلة”، إنْ جرى تقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات حسبما أعلن عنه وزير الداخلية السوري في الآونة الأخيرة.
ديناميكيات التفاعل السلبي بين المكوّنات السورية، ومهما بلغت من التعقيد، ليست كافية لتكون دلائل حاضرة على وجود مشكـلة طائفية حقيقية ومتجذّرة
بالتساوق مع ما تقدّمـ يقع على عاتق السلطة الحالية مسؤولية خلق وعي سياسي ووطني ضمن فضاءات مدنية واسعة، لردع الخطابات الديماغوجية الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك المهرجانات الدعوية الكاريكاتورية والتجاوزات المستفزّة، التي لم تكن مجرّد تصرّفاتٍ خرقاء فردية من متديّنين متشددين ومتحمّسين، إذ كشف زخمها مستويات عالية لخطاب الكراهية والإقصاء، أيضاً تسويق مصطلحَي الأغلبية “المُباركة” والأقلية “المُدانة”، ما يمثّل عصياناً يمهد لحالة انقلابية على الهوية الوطنية الجامعة، وإشاعة حالة عدم يقين في وقتٍ تحتاج البلاد فيه إلى رأب التصدعات وهدم الجدران العازلة التي خلّفها النظام البائد، الذي روّج كذبة كبيرة أنه “حامي” الأقليات. لنتذكّر: عند تأسيس الجيش السوري عام 1945، نُقلت إليه كلّ مقدرات جيش الشرق البشرية، ومنها العلويون، الذين وجدوا أنفسهم بين الآباء المؤسسين للمؤسسة العسكرية، ولم يكونوا منبوذين ومضطهدين، كما ادّعى حافظ الأسد. وعلى السوريين اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، دحض تلك الأكاذيب، واستنكار المصطلحات المتداولة عن سُنّة أكثرية في دولة أموية يُعاد إنعاشها قسراً، بصفتها انحرافاً كارثياً عن طريق بناء بلد عابر للطوائف والأعراق.
فعلياً، لا توجد حساسية طائفية إلاّ عند من يتبنّاها ويسوّقها، بالتالي فإنّ التضخيم المغرض للسرديات الطائفية وارتفاع الأصوات المحرّضة، هدفه تسهيل الطريق لتمزيق النسيج الاجتماعي، بداية في الساحل السوري، ولاحقاً في البيئة الدرزية بعد التسجيل الصوتي المفبرك وتداعياته الكارثية، وعلى الطرف الآخر ترتفع نسبة شيطنة “الأكثرية” من قبل “أيتام الأسد”، وشيطنة “الأقليات” من قبل المتطرفين الحاقدين، إضافة إلى باقي الطوائف والإثنيات، خصوصاً الكردية التي لا تخفي مخاوفها الوجودية من المستقبل…إلخ، هذه الدوامة الطاحنة لم تُوقع السوريين في الفـخّ الطائفي المُحكم، بدلالة أنه وفي الوقت الذي تظهر به أصوات تتناول مجريات الأحداث المشتعلة بأبعاد طائفية وبلغة عنصرية مقيتة لا تخدم إقامة السلم الأهلي، تظهر أصوات مقابلة تُدين هذا “الزعيق الطائفي” وتسخّفه في مكان. وخير دليل على ذلك ملصقاتٌ عُلّقت في اللاذقية تدعو إلى تكفير العلويين، ليزيلها عقلاء من السنّة على الفور.
وعليه، التذكير بأسباب الطائفية ليس مجرّد اجترار مجاني للماضي وإنما إنعاش للوعي المغيّب بما يجب أنّ يُعلَمَ بالضرورة، ومن ثمّ، فإنّ استحضار أحداث حماة (1982)، مثلاً، والتي فعّلت نبرة الطائفية إلى الحدود القصوى بعدما كانت في مستواها الأول غير الملموس، مدخلٌ لازم للبحث في سُبل الشفاء من اللعنة السوداء التي فُرضت على السوريين وأصبحت ملازمة لهم، بعدما دفعهم نظام الأسد للتمسك بهوية إيمانية دوغمائية تضع الذات في مفارقة جدلية عقيمة مع الآخر المختلف لفرض حالة تضاد صدامي صالحة دائماً للاستثمار، ما يجعل اللوحة الفسيفسائية السورية المصطلح الأكثر ابتذالاً الذي عرفه السوريون يوماً.
نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم
بطبيعة الحال، يُجمع مراقبون على أنّ الطائفية بمزاجها المتشدّد دخيلةٌ على المجتمع السوري المتسامح نسبياً، ولا شك مرّت نزعة “الشِقَاق الوطني” بمحطات هبوط وصعود بلغت مداها في عهد نظام الأسد، الذي رعاها ضمناً وأنكرها علناً، معيداً ترتيب مفردات الاختلاف الطبيعي بين المكونات السورية لتخديم سلطته العميقة وتكوين آلته القمعية. وحين رُفع غطاء الجحيم عن البلاد أخيراً بإعلان نهاية حكم الأبد إلى غير رجعة ظهرت أمراضٌ مجتمعية ساهم في صناعتها، وهي، في جوهرها، ليست إلاّ سجال الألم وسعار الغضب اللذين ينتهيان دائماً إلى عباراتٍ سامّة، من قبيل “نحن” و”هم”. واليوم، وفي لحظة مفصلية حرجة تشهدها سورية والمنطقة، المتاح إما مصالحة وطنية تُنهي تراشق التهم الطائفية بين الأطراف المختلفة أو أن تغدو التحالفات والأيديولوجيات سبيلاً لتثبيت مشروع “أفغنة” الدولة، وهي أفضل السيناريوهات الممكنة حينها، أو لمشروع احترابٍ دموي دائم في أسوئها.
يتوجب الجزم بيقين أنّ المشكلة الطائفية لم تنشأ بسبب التنوّع وتناقض مصالح الطوائف، بل تكمن أساساً في الاستثمار السياسي فيها، ولا يمكن اجتثاثها من جذورها إلا بترسيخ أسس الديمقراطية الفعلية، بعيداً عن منطق المحاصصة. والواقع أنّ ضرب الخطاب الطائفي لن يتمّ إلا مع سقوط الحاضن الأول له، وأقصد تركة الأسد، على القدر نفسه من الأهمية، بوقوف السوريين جميعهم بحزمٍ ضد التخوين والعنصرية، خاصة تحريض سوريّي الخارج وقراءتهم مسبَقة الصنع للمشهد السوري، والذين انتقلوا بسرعةٍ مريبة من الانتقاد إلى مدافعين شرسين عن الحكومة الجديدة، لإيمانهم أنَّ “القوة دائماً على حقّ”. ولا نبالغ إذ نقول إنه ينطبق على الطائفية السورية توصيف “قميص عثمان المُدمّى”، الذي رفعه بنو أمية والنيّة المُضمرة لم تكن الثأر لعثمان، بل الوصول إلى نيل السلطان، واليوم تشهد الفضاءات السورية العامة ارتفاعاً مهولاً وممنهجاً في الخط البياني لخطاب العدالة “الانتقامية” بقصد الهيمنة والتمكين، ما يؤكد على رُدّة وطنية للوافدين من أماكن التطرّف، وربما القهر، وبذريعة الشعار الأكثر استبداداً “من يحرّر يقرّر”.
نافل القول: تراجع الأزمة السياسية سينجم عنه بالضرورة تراجع في التوتر الطائفي، أما التعامل معه، بوصفه تحصيل حاصل لما تقدّم ذكره، فضرورة ملحّة لا تستوجب الإنكار أو التأجيل، باعتباره آفة مارقة تجعل التسليم بزواله نتيجةً لا جدال حولها. بالتالي، نضال السوريين ضد الطائفية جزءٌ من النضال من أجل تشكيل معرفة وطنية تليق بالفرصة التاريخية التي مُنحت لهم، لمواجهة خطر هذا الطاعون القاتل، ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، لأنه، ببساطة شديدة، مصدرُ تفرّق وعداوة ضدّ التنوع والاختلاف، وأيضاً ضدّ الحياة.
العربي الجديد
———————–
“المجلس العسكري” في السويداء… لماذا تشكل الآن؟/ عباس شريفة
مستقبله مرهون بقدرته على تجاوز عزلته المحلية
آخر تحديث 23 مايو 2025
احتجز مسلحون محافظ السويداء مصطفى البكور، للضغط على دمشق لإطلاق معتقلين متهمين بجرائم. وكانت “وكالة الأنباء السورية الرسمية” (سانا) نقلت عن مصدر أمني في السويداء، قوله إن مجموعة من “المجلس العسكري” في السويداء استهدفت يوم 6 مايو/أيار2025 سيارة للأمن العام، تقل مصابين من أبناء السويداء، إلى محافظة درعا لتلقي العلاج.
لا علاقة مباشرة بين الحادثتين، لكنهما جاءتا بعد اتفاق بين محافظ السويداء، ووجهاء المحافظة على نشر الأمن العام في المحافظة، بحيث تكون العناصر من أبناء المحافظة نفسها، فيما يبدو أن الهدف من الاستهداف، هو إجهاض الاتفاق والعودة إلى مربع التوتر والتجييش، الذي شهدته المحافظة بعد أحداث جرمانا وصحنايا، وهم مدنيون من محافظة ريف دمشق التي تقطنها شريحة من المكون الدرزي، وانتهت المشكلة في المدينتين بالاتفاق على نشر الأمن العام فيهما، وسحب السلاح العشوائي منهما، الأمر الذي أوجد تخوفات لدى “المجلس العسكري” في السويداء من امتداد هذا الاتفاق إلى المحافظة، وهو ما يعني إنهاء دور “المجلس” نهائيا.
في هذا المقال سنتعرف على “المجلس العسكري” من حيث الأجندة السياسية التي يعمل لأجلها، وحجم النفوذ الذي يتمتع به في السويداء، والبنية التنظيمية لـه، ومستقبله في سياق المتغيرات الحاصلة في العلاقة بين الحكومة السورية، وباقي الفاعلين في السويداء.
شُكِّل “المجلس العسكري” في بلدة الغارية بمحافظة السويداء منذ 24 فبراير/شباط 2025، أي بعد سقوط نظام الأسد، وهو اتحاد مجموعات مسلّحة بقيادة طارق الشوفي، باستثناء “لواء الجبل”، و”مضافة الكرامة”، و”أحرار الجبل” بقيادة سلمان عبد الباقي، وليث البلعوس، ويحيى الحجار.
يتميز “المجلس العسكري” في السويداء بتنظيم عسكري وإداري متكامل، يهدف إلى إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية في المحافظة، ويعكس وجود توجيهات استخباراتية خارجية في تأسيس بنيته الداخلية. ويضم “المجلس العسكري” ما لا يزيد على 800 مقاتل بحسب بعض التقديرات، بينما يدّعي “المجلس” أن عدد منتسبيه بلغ 22 ألف منتسب. وهو فصيل يتكون غالبه من أبناء الطائفة الدرزية.
ويُتهم “المجلس” بأنه على “تنسيق مع إسرائيل” بسبب تزامن التشكيل، مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يتحدث عن حماية الأقلية الدرزية جنوبي سوريا، ومطالبته بنزع السلاح من حكومة دمشق في محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا.
ويؤكد الشوفي تنسيقه مع دول التحالف الدولي، موجّها الشكر لكل من يساند موقفه، ويسهم في حماية الطائفة الدرزية واستقرار المنطقة.
ويؤكد “المجلس العسكري” في بيانه التأسيسي على مجموعة من المهام، هي: حماية الأرض والعِرض من أي تهديد داخلي أو خارجي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولة لزعزعة أمن السويداء، وحماية جميع المواطنين دون تمييز.
كما يؤكد على مجموعة من الأهداف تتلخص في: ضمان الأمن والاستقرار في السويداء، والحفاظ على تماسك المجتمع وتضامنه، والعمل على تأسيس بيئة آمنة تضمن حرية المواطنين وكرامتهم، والتنسيق والتعاون مع كافة القوى الوطنية والدولية التي تسعى لمصلحة الشعب السوري.
رؤية “المجلس العسكري” لسوريا أنها دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها. وقد اعتمد “المجلس العسكري” في السويداء علما يحمل خريطة سوريا، وهو العلم نفسه الذي تستخدمه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والذي يفصل الأراضي التي تسيطر عليها “قسد” شرق الفرات عن بقية سوريا. والتعديل الوحيد هو إبراز محافظة السويداء بالنجمة الخماسية الدرزية.
قائد “المجلس العسكري” في السويداء طارق الشوفي
وأعرب “المجلس العسكري” عن انفتاحه على التعاون مع “قسد”، مشيدا بها كقوة دافعت عن أرضها وشعبها ضد الإرهاب والدكتاتورية. كما أعلن تأييده طلب الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في البلاد، حكمت الهجري، الحماية الدولية بعد أحداث جرمانا، وأشرفية صحنايا في ريف دمشق.
الشوفي هو ضابط في جيش النظام السابق، انشق عن النظام عام 2015، وأعلن عن تأييده للحراك في السويداء عام 2023، وشارك في المظاهرات في ساحة الكرامة. وكان الشوفي حينها ينتمي لما سُمّي “تيار سوريا الفيدرالية”، ويدعو إلى دولة لا مركزية في سوريا.
البنية العسكرية والنفوذ
يقود “المجلس العسكري” 13 ضابطا هم قادة “المجلس”. ويتألف الشكل التنظيمي للمجلس من عدد من الوحدات، والألوية، والكتائب، والسرايا، على النحو التالي:
أ- الوحدات العسكرية الرئيسة:
لواء حرس الحدود: مسؤول عن تأمين حدود المحافظة ومنع التسلل أو التهديدات الخارجية، مع التركيز على المناطق الريفية المحيطة.
لواء المهام الخاصة: وحدة نخبة تتولى تنفيذ العمليات السريعة والمعقدة، مثل التصدي للتهديدات الإرهابية أو تنفيذ العمليات الخاصة خارج السويداء إذا لزم الأمر.
لواء مغاوير “المجلس العسكري”: قوة قتالية مدرّبة على القتال في التضاريس الجبلية، تُستخدم في الدفاع عن المواقع الاستراتيجية، وتنفيذ العمليات الهجومية.
كتيبة مكافحة الإرهاب: متخصصة في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية، خاصة في ظل استمرار تهديد خلايا “داعش” في البادية المجاورة.
كتيبة تأمين الطرق والقوافل: تُعنى بحماية الطرق الرئيسة وتأمين حركة الإمدادات والمواطنين بين القرى والمدن.
سرية الشرطة العسكرية: مسؤولة عن الانضباط داخل الوحدات العسكرية، وملاحقة المخالفات العسكرية والمدنية المرتبطة بـ”المجلس”.
ب- الأقسام الإدارية والداعمة:
مكتب المستشارين العسكريين: يضم خبراء عسكريين يقدمون الاستشارات الاستراتيجية لقيادة “المجلس”، مع التركيز على التخطيط طويل الأمد.
مكتب الأمن العام: يراقب الأوضاع الأمنية الداخلية، ويجمع المعلومات حول التهديدات المحتملة، وينسق مع الوحدات الميدانية.
المكتب السياسي: يتولى صياغة الرؤية السياسية للمجلس، والتواصل مع القوى السياسية المحلية والدولية، ويمثله شخصيات مثل جيهان المحيثاوي.
القسم الإداري والمالي: يدير الموارد المالية واللوجستية، بما في ذلك توزيع الرواتب والإمدادات على الوحدات.
قسم التنظيم: مسؤول عن هيكلة الوحدات، وتنظيم الصفوف، وضمان التكامل بين الأقسام المختلفة.
قسم العمليات: يخطط وينفذ العمليات العسكرية، ويراقب التحركات الميدانية في الوقت الفعلي.
قسم الإشارة: يدير الاتصالات بين الوحدات، ويضمن استمرارية التنسيق باستخدام أنظمة الاتصال الحديثة.
قسم الهندسة: يتولى بناء التحصينات، وإزالة الألغام، وصيانة المعدات العسكرية.
قسم المدفعية: يشرف على الأسلحة الثقيلة والدعم الناري، ويُستخدم في حالات الدفاع أو الهجوم الواسع.
قسم القضاء العسكري: يتولى التحقيق في الجرائم العسكرية، ومحاكمة المخالفين وفق قانون عسكري داخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن “المجلس” آخذ في التوسع، وقد شهد مؤخرا انضمام فصائل جديدة، أبرزها: فصيل “قوات الجنوب”، و”العانات”، وتجمع “شباب حِبران”.
التمويل والدعم
يعاني “المجلس العسكري” في السويداء من أزمة تمويل، حيث هاجم شبان مسلحون منزل طارق الشوفي، مطالبين بتسليم رواتبهم التي لم تُصرف. وأوضح “المجلس العسكري”، في بيان صادر بتاريخ 22 مارس/آذار، أن الشبان أطلقوا النار بشكل عشوائي، متهما “جهات معلومة”– لم يُسمّها– بالتحريض على هذا التصرف، بهدف التشويش على “نجاحات (المجلس) في توحيد الصفوف داخل المحافظة”.
وأكد “المجلس العسكري” أنه لم يقدّم أي وعود بدفع رواتب للمنتسبين، قبل افتتاح مكاتب الانتساب رسميا وتسجيل عقود التطويع، مشددا على التزامه بالشفافية، والصدق في التعامل مع المجتمع المحلي، ومعتبرا أن “هذه الأعمال العبثية” لن تؤثر على مساعيه في “بسط الأمان والاستقرار في السويداء”.
ورغم ذلك، لا يُخفي “المجلس العسكري” قبوله التعامل مع إسرائيل، إذ تشير بعض المصادر إلى أن تمويله يأتي عبر رجل الدين موفق طريف، المقيم في إسرائيل. كما يُعدّ الشيخ حكمت الهجري القائد الروحي والديني والسياسي للمجلس، ما يمنحه دعما معنويا في السويداء أمام الفصائل الرافضة لوجوده.
علاقة “المجلس” بالحكومة السورية
يتبنى “المجلس العسكري” موقفا عدائيا واضحا من حكومة دمشق، إذ يهاجم الشوفي الحكومة، ويرفض التعامل معها، واصفا إياها بـ”سلطات الأمر الواقع”. ويدّعي “المجلس العسكري” أنه يستمد شرعيته من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري.
وقد أصدر المكتب السياسي لـ”المجلس” بيانا أعلن فيه عدم اعترافه بالحكومة الانتقالية، واصفا إياها بـ”حكومة اللون الواحد”، كما رفض الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة السورية، وطالب بإقامة نظام حكم علماني ديمقراطي لا مركزي، وهي مطالب تتقاطع مع مطالب “قوات سوريا الديمقراطية” في تكريس اللامركزية بصيغتها الفيدرالية.
هذا الموقف أثار بعض الحساسيات، إذ قامت “قوات الأمن العام” في 6 أبريل/نيسان 2025 باعتقال 25 عضوا من أعضاء “المجلس العسكري” في السويداء، أثناء توجههم إلى مدينة الرقة لحضور اجتماع مع قيادات من ميليشيا “قسد”، بدعم من الشيخ حكمت الهجري. وقد أثار ذلك استياء مجموعات متعددة من فصائل الدروز، ما دفع حكومة دمشق إلى المسارعة بالإفراج عنهم، وإعادتهم إلى السويداء، منعا لتصعيد محتمل بين الطرفين، وذلك بعد ساعات من احتجازهم في مدينة حمص.
عليه، يمكن القول إن توقيت تشكيل “المجلس العسكري” في السويداء جاء كمحاولة من بعض الضباط والعناصر العسكرية في المحافظة، لتأسيس كيان عسكري منظم، يسعى إلى لعب دور محوري في إعادة تشكيل معادلات القوة والنفوذ على المستوى المحلي. ويبدو أن هذا التشكيل يطمح إلى بناء تحالفات استراتيجية مع “قوات سوريا الديمقراطية”، بهدف خلق جبهة مناهضة لحكومة دمشق، مدعومة خارجيا، ما قد يمكّنه من فرض شروط تفاوضية جديدة على النظام، بعد فرض سيطرته على السويداء. ويعكس اختيار ضباط لقيادة “المجلس”، بدلا من رجال الدين، توجّها نحو بناء مؤسسة عسكرية ذات طابع مهني، تسعى إلى كسب الشرعية من خلال الأداء والتنظيم، وليس فقط من خلال الغطاء الديني.
غير أن طموحات “المجلس” تصطدم بجملة من التحديات البنيوية والواقعية؛ فالصراع على النفوذ والزعامة داخل السويداء لا يزال محتدما، و”المجلس” لا يمتلك بعدُ القوة أو الامتداد الشعبي الكافي لتجاوز الفصائل المحلية المتجذّرة، التي تتمتع بنفوذ أوسع وموارد أكبر. كما أن تحالفه مع الشيخ حكمت الهجري، رغم ما يمنحه من غطاء معنوي وروحي، لم يكن كافيا لتحييد خصومه المحليين أو توسيع قاعدة شرعيته.
على المستوى السياسي، ترفض حكومة دمشق الاعتراف بـ”المجلس” أو التعامل معه، بسبب خطابه التصادمي وسلوكه المعادي، فضلا عن الاتهامات التي تلاحق بعض قادته بتنفيذ أجندات إقليمية، تصبّ في مصلحة إسرائيل، التي تُتهم بالسعي إلى توظيف “المجلس”، كأداة لاختراق الجنوب السوري، وترسيخ وقائع جيوسياسية تمهّد لتقسيم فعلي للبلاد.
كل ذلك يجعل مستقبل “المجلس العسكري” في السويداء مرهونا بقدرته على تجاوز عزلته المحلية، وتوسيع تحالفاته الداخلية، وإثبات استقلالية قراره، بعيدا عن الشبهات الخارجية، في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية والدولية.
المجلة
—————————
الأزمة الطائفية وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الأسد/ أحمد عيشة
2025.05.24
انتقل الصراع في سوريا، بعد الخلاص من بشار الأسد، إلى صيغة جديدة تتمحور حول طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم الاقتصادي والسياسي.
لم يخرج الصراع هذا عن الجذور العقائدية/الأيديولوجية للمشتغلين في الشأن العام من تيارات سياسية، أو شخصيات مستقلة ومثقفين، ناهيك عن الأصوات المعبرة عن الطوائف، التي برزت مؤخراً بمجالسها وشيوخها وطغت على المشهد برمته، معبّرة عن وجهات نظر كانت مدفونة وكان التعبير عنها ممنوعًا.
ورغم التوافق الظاهري حول شكل الدولة بأنها مدنية تقوم على حق المواطنة وتمثيل الجميع، إلا أن ذلك التوافق كشف عن رؤى تفتيتية للبلاد، ونموذج تمييزي من المواطنة. بكلمات عامة، كانت المطالب تتركز حول امتيازات لجماعات عانت من الظلم، ولأخرى كي لا تتعرض للظلم، مما يُخفي كثيراً من المواقف الطائفية خلف ادعاءات بمعارضة طائفية السلطات الجديدة، كونها انبثقت عن تنظيم سلفي جهادي، في حين كان الصوت الوطني الديمقراطي هو الأضعف إن لم يكن غائبًا.
فرضت فرنسا، في إطار رؤيتها الاستعمارية، شكل الكيان السوري بما يتعارض مع تطلعات سكانه، بهدف تقسيم البلاد لضمان السيطرة، من خلال دويلات تقوم على أسس طائفية. بعد الاستقلال، اندفع أبناء الأرياف والأقليات الذين عانوا من التهميش لفترات طويلة لللالتحاق بالجيش وأيضاً بالأحزاب، وخاصة ذات المنحى الاشتراكي، حيث تمكنوا بعد سنوات من الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب 1963، الذي سيطر فيه حزب البعث على الحكم بدعم من لجنة عسكرية سرية معظم أعضائها من الأقليات، من بينهم حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة عام 1970، بعد صراع داخلي في الحزب، أنهى مرحلة من حكم يساري الشكل، وأسس دولة أمنية مركزية، وضع فيها أقاربه ومعارفه من الطائفة في مواقع حساسة، ومنح بعض السنّة مناصب شكلية دون سلطة فعلية، فخلق سلطتين: الأولى ذات تركيبة طائفية في الجيش والمخابرات وهي الحاكم الفعلي، والثانية شكلية تشمل الجميع، وهي واجهات لا أكثر.
باختصار، تحوّل النظام إلى حكم طائفي بواجهات “وطنية”، ما جعل بنيته طائفية وشكله “وطنيًا”.
لمحاولة فهم ما حدث ويحدث في سوريا، من الضروري تحديد مستويات الصراعات في البلاد، وهي متنوعة وذات أبعاد طبقية، وريف-مدينة، وطائفية، لكن الطابع المهيمن في سلطة الأسد هو الطائفي، الذي تجلى بتركيبة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المعارضين والثوار بطريقة تمييزية (عنف معمم في مناطق ومخصص في أخرى)، حيث خلق التعامل الوحشي ردات فعل طائفية مقابلة وساهم في تأسيس تيارات ذات نزعة طائفية أيضاً. إن تفسير كل ما جرى ويجري في سوريا وفق البعد الطائفي فقط غير كافٍ؛ فهو يوفر تفسيرًا أحاديًا لظاهرة معقدة لها جذور تاريخية عميقة. لذلك، لا بد قبل محاولة التفسير من توضيح بعض المفاهيم: ما هي الطائفية، وما هو الدور المحوري الذي لعبته في الصراع؟ من المهم أيضًا معرفة التركيبة الديموغرافية في سوريا لما لها من دور في فهم الصراع ككل.
الطائفية حسب برهان غليون “نتاج لغياب الدولة الوطنية الحديثة وفشل مشروع المواطنة”، وحسب عزمي بشارة: “استخدام سياسي للهويات الدينية في صراع المصالح”، فهي فعل سياسي للسلطات أو القوى المتصارعة على السلطة قائم على التعصب والتمييز والمصالح، يركز على الاختلافات المتخيّلة بين الجماعات الدينية ويجعل منها أساساً لخندقة تقوم على “نحن” و”هم”، و”هي”. بمعنى ما، تسعى الطائفية إلى تحويل الاختلافات إلى أساس لصراع وجودي: إما نحن أو هم، وتلغي إمكانية التفاهم بين الطرفين، وتدعو إلى أشكال من التطهير أو الإبادة.
لم يكن الصراع الطائفي جديداً في سوريا، فهو يعود لبدايات تشكل الكيان السوري، لكنه أصبح محوريًا في فترة الأسدية التي اعتمدت في حكمها على القوة العارية للجيش والمخابرات ذوي الهيمنة الطائفية، التي حولت سوريا ذات التنوع في تركيبتها السكانية إلى مصدر للانفجار والاقتتال بدل أن تكون مصدراً للقوة من خلال الاعتماد على قاعدة طائفية من جهة وتشجيع العداوات المتخيلة بين تلك الجماعات من جهة أخرى، مع العلم أن تلك الجماعات السكانية، وبغض النظر عن النسب، ليست كتلة صماء، وإنما تتباين في المواقف والمصالح وتخضع لتناقضات داخلية وصراعات مثلها مثل أي جماعة أخرى، يتشابك فيها الديني مع السياسي مع الاقتصادي (المصالح).
خلقت هذه الهيمنة مظالم كبرى، زادت من تأجيج الصراع، خاصة بعد الثورة وما شهدته من فظائع ارتكبها النظام بحق السوريين، إلى درجة أن الطائفية أصبحت خط الصدع الوحيد الذي يتمتع بسلطة فعّالة على الجميع. ورثت الإدارة الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام بلداً مدمراً يعاني من الفقر والتهميش والانقسامات الطائفية. وهي انقسامات عميقة يتأثر بها الجميع، يبدو الخلاص منها حتى على مستوى الخطاب أمرًا يحتاج إلى سنوات طويلة. وهذا يتطلب من الجميع وخاصة من السلطة بناء خطاب وممارسة دقيقتين، يركزان على خلق التقارب والوحدة بين مختلف الجماعات الإثنية والدينية، فمستقبل سوريا يكمن في القدرة على بناء هذا الخطاب والسلوك، كما أن الفشل في ذلك قد يدخل البلاد في حرب أهلية مدمرة.
مثلت أحداث آذار في الساحل، وما تلاها من تطورات في السويداء وبعض مناطق ريف دمشق (جرمانا وأشرفية صحنايا)، الاشتباك الأول للخطاب السياسي مع حالة الانقسامات تلك، حيث أخذ شكلاً انفجارياً يعكس عمق الأزمة الطائفية. فالخطاب الذي تقدمه تلك الجماعات حول شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي كان خطاباً أيديولوجياً يسعى لتعبئة طائفية، ومحاولة للحفاظ على امتيازات قديمة أو خلق أخرى جديدة، مع نزعات تفتيتية، فلم يكن حديثهم عن دولة المواطنة سوى قناع زائف لمطالب أخرى. ونتيجة ربط النظام للطائفة بوجوده، بغض النظر عمّا إذا كان جميع أفرادها موافقين أو مستفيدين، وفي ظل غياب صوت جماعي يرفض الفظائع التي ارتُكبت خلال الثورة (رغم وجود أصوات فردية معارضة)، وجد العلويون أنفسهم محاصرين بين مطرقة الانتقام وسندان النظام، وضحايا لتلك السياسة.
يتفق معظم السوريين، في الخطاب، على قيام دولة قانون تحقق الكرامة والحرية، لكن تظهر التناقضات والصراعات حول مضمون هذه الدولة وطريقة تحقيقها، ما يكشف عن عمق الجذور الطائفية التي تغلف الممارسة السياسية والمصالح الضيقة وتفقدها مصداقيتها. ومن جانب آخر، يظهر ضعف بنية الجماعات السياسية. كان غياب صوت العقل والنقد الموضوعي هو السائد، باستثناء بعض الأصوات الفردية، حيث غابت السياسة بمعناها الحقيقي كصراع وتسويات بين قوى اجتماعية، وتحولت إلى اشتراطات وطلبات واجبة التنفيذ.
أمام هذه التركيبة والصدوع العميقة، يبقى المخرج الوحيد هو العمل على بناء دولة من خلال تأسيس جيش وقوات أمن على أسس وطنية مهنية، تبسط سيطرتها على كامل التراب السوري. دولة تعمل على بناء هوية وطنية سورية تقوم على المواطنة التي تساوي بين الجميع، وتخلص البلاد من منطق الأكثرية والأقلية القائم، دون تمييز لجماعة على أخرى تحت ذريعة حماية الأقليات كما يطالب البعض في الداخل والخارج، وتقوم على نظام يعتمد التنوع السياسي أولاً، الذي يضمن سلامة التنوع الثقافي والاجتماعي لا العكس، ويكفل مشاركة عادلة للجميع، وأولى تلك الخطواب بناء جيش وقوات أمن على أسس وطنية، وهو انجاز هائل إن تمكنت الحكومة الجديدة من تحقيقه، إضافة للتخلص من المناهج التعليمية المتعددة ذات الصبغة الأيديولوجية، والاهتمام بمسألة العدالة الانتقالية من خلال محاسبة رمزية أو فعلية على الجرائم والانتهاكات.
ويبقى في النهاية القول إن فهم الأزمة السورية من منظور طائفي فقط هو فهم تبسيطي، يتجاهل تعقيدات أخرى مثل: الصراعات الاجتماعية البينية، والقوى الخارجية ونزعات الهيمنة لديها، والنظم السلطوية. فالطائفية ليست سوى واحدة من أدوات التدمير لدى القوى المهيمنة، كما أن الخلاص منها هو عملية سياسية بامتياز، طويلة الأمد، تبقي على التنوع في إطار الوحدة، فمصدر قوة البلدان اليوم تنوعها، ومستوى الحرية فيها.
تلفزيون سوريا
—————————————
احتضان ترامب للرئيس السوري الشرع يعيق استراتيجية إسرائيل التوسعية في سوريا
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده مايكل شير، قال فيه إن تقارب ترامب مع سوريا يعقد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
ومنذ لقاء ترامب مع الرئيس السوري الجديد، تراجعت الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد. وقالت الصحيفة إن إسرائيل شنت أكثر من 700 غارة على سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، بما في ذلك ضرب مواقع قريبة من القصر الرئاسي في دمشق. وزعمت إسرائيل أن الهدف من هذه الغارات كان منع الأسلحة الوقوع في أيد معادية والحد من قدرة الحكومة الجديدة على ترسيخ قوتها في جنوب سوريا.
وقال أوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “هذا بالتأكيد درس من جنوب لبنان”. وأشار أراد الناقد حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السنوات التي قضتها إسرائيل في مواجهة الجماعات الفلسطينية وحزب الله في جنوب لبنان، حيث شنت هجمات على شمال إسرائيل.
كما وصفت إسرائيل الحكومة السورية الجديدة، التي يترأسها زعيم كان مرتبطا مرة في القاعدة بأنها “متطرفة”. ولكن بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية في 2 أيار/مايو قرب القصر الرئاسي في دمشق، قلب الرئيس ترامب عقودا من السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب باجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وإعلانه عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.
وقال ترامب إن لدى الشرع “فرصة حقيقية لإعادة بناء البلاد”، بعد حرب أهلية مدمرة دامت قرابة 14 عاما.
ومنذ ذلك الاجتماع في 14 أيار/مايو، توقفت الضربات الإسرائيلية على سوريا تقريبا. ومع أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل إلا أن التقارب الأمريكي- السوري واحتضان الشرع لم يمنحا الرئيس السوري طوق نجاة غير متوقع فقط، بل وقوضا على ما يبدو جهود الحكومة الإسرائيلية المتشددة لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحكومة الجديدة لمنع صعود جار آخر معاد لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن كارميت فالنسي، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب “لدى إسرائيل شكوك عميقة حول نيته وصورته البراغماتية التي يحاول تقديمها”، في إشارة للشرع.
وقبل منح ترامب الثقة للشرع، حاول نتنياهو وقادته الكبار حرمان الحكومة الجديدة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسلحة الثقيلة التي جمعها نظام الأسد على مدى عقود من حكمه. وقالت فالنسي: “كان الجزء الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية موجهًا ضد أسلحة استراتيجية كان الجيش السوري السابق يملكها”، مضيفةً أن الحكومة الإسرائيلية يبدو الآن أنها بدأت في إيجاد طرق لتجنب المزيد من المواجهة. وقالت: “كل هذا يشير إلى اتجاه لخفض التصعيد ومنع الصراع، واستعداد أكبر لفتح حوار مع النظام السوري”.
وبرر المسؤولون الإسرائيليون دوافعهم للهجوم على سوريا، بالدروز، حيث يعيش منهم 150,000 في إسرائيل ويخدمون في الجيش الإسرائيلي. وفي بيان للجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أكد مساعدة المجتمعات الدرزية في سوريا وأنها “نابعة من التزام لإخواننا الدروز في إسرائيل”. ويعيش دروز سوريا في السويداء ونادرا ما شكلوا تهديدا على إسرائيل.
وفي نهاية نيسان/أبريل، عندما اندلعت اشتباكات طائفية عنيفة بين ميليشيا درزية وقوات مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، عرضت إسرائيل مساعدة الدروز. وصور القادة الإسرائيليون الغارة قرب القصر الرئاسي بأنها تحذير للشرع لوقف الهجمات على الدروز، مع أن دوافع الجهات الأخرى على سوريا خلال الأشهر الماضية تتجاوز دعم الدروز.
وبدأت إسرائيل هجماتها على سوريا حالا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر. ونفذت في أسبوع واحد 450 غارة تقريبا. وأدت الهجمات إلى تدمير البحرية السورية بأكملها والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف في جميع أنحاء البلاد، حسب قول الجيش الإسرائيلي.
كل هذا مع أن الحكومة السورية الجديدة لم تهاجم إسرائيل منذ توليها السلطة، وقالت إن البلاد تعبت من الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول.
وعليه، فغصن الزيتون الذي قدمه ترامب للشرع يعقد الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا، وهو أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط. وقال يعقوب أميدرور، وهو مستشار سابق آخر للأمن القومي لنتنياهو وزميل في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي: “ما لا نريده في سوريا هو نسخة أخرى من الحوثيين”.
ويشكك نتنياهو ومن حوله في مواقف الشرع وحكومته ويعتقدون أنها ستتطور نحو حكومة إسلامية معادية لإسرائيل.
وسخر جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في آذار/مارس من فكرة ظهور حكومة عقلانية في سوريا وقال إنها فكرة “سخيفة”، مضيفا أن الشرع وجماعته “جهاديون وسيظلون جهاديين حتى لو لبس بعض قادتهم البدلات”. إلا أن الهجوم الواسع النطاق على سوريا أثار انتقادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى الشرع في منتصف أيار/مايو. وقال ماكرون عن إسرائيل: “لا يمكنك ضمان أمن بلدك بانتهاك سلامة أراضي جيرانك”. وهناك البعض داخل إسرائيل يقولون إن حملة عسكرية منسقة لن تكون في مصلحة إسرائيل، على المدى البعيد.
ويعتقد محللون عسكريون أن الهدف وراء التوسع في سوريا هو ضمان أمن الجولان، حيث استولت إسرائيل على مناطق واسعة من جنوبي سوريا. وهناك عامل آخر وهو الحد من تأثير تركيا في سوريا. ولكن قد تكون جهود الولايات المتحدة للتقارب مع سوريا هي التي تعيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.
————————————
أردوغان للشرع: لا يمكن قبول احتلال إسرائيل وعدوانها على أراضي سوريا
أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات.
جاء ذلك خلال لقاء جرى بين أردوغان والشرع، اليوم السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول،وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
ووفقا للبيان، أعرب أردوغان خلال اللقاء عن اعتقاده بأن أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا، مؤكدا أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب دمشق كما فعلت حتى الآن.
وقال أردوغان للشرع الذي يجري أول زيارة له إلى تركيا بعد أن قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، إن أنقرة ترحب برفع العقوبات.
وأكد الرئيس التركي أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإدارة البلاد والجيش من مركز واحد.
وشدد على أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر لا يمكن قبوله، وأن تركيا ستواصل معارضته.
كما أكد مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا في كافة المجالات، وخاصة الطاقة والدفاع والنقل.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة مع سوريا، كما فعلت حتى الآن.
من جهته أعرب الشرع عن شكره لأردوغان على دعمه الحاسم وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق جورجون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، وكبير مستشاري الرئيس سفر توران.
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت على رأس وفد حكومي إلى تركيا.
ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، يرافق الرئيس الشرع في زيارته إلى تركيا وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يلتقيا نظيريهما التركيين لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وطبقا لوكالة الأناضول ، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري في إسطنبول، مشيرة إلى أنه حضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق جورجون.
(د ب أ)
—————————————
توغلات إسرائيلية جديدة.. إشارات معاكسة لـ”مسار التطبيع“
24 مايو 2025
شكّل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب نقطة تحول مفصلية، حيث طُرحت فكرة التطبيع بين دمشق وتل أبيب بشكل علني للمرة الأولى، في سياق الشروط الأميركية على دمشق لرفع العقوبات، الأمر الذي استبقته سوريا بإرسال تطمينات أمنية للجانب الإسرائيلي، وإجراء محادثات غير مباشرة أعلنت عنها في سبيل إنهاء الاعتداءات المتكررة عليها.
وفي ظل الهدوء الحذر، عاودت الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها في القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي، لا سيما مناطق ريف القنيطرة الجنوبي مثل كودنة، وصيدا الحانوت، والرفيد، وسد المنطرة، إضافةً إلى مناطق أخرى مجاورة، ما طرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الإسرائيلية لهذا لتوغل في ظل مسار سياسي مستجد للعلاقات السورية مع إسرائيل.
تغيير قواعد الاشتباك
يعتقد الكاتب السياسي والمختص في الشؤون الإسرائيلية، محمد أبو شريفة، أن إسرائيل تحاول من خلال توغلاتها إرساء قواعد جديدة للاشتباك تختلف عما تم الاتفاق عليه عام 1974 (اتفاق فض الاشتباك)، وذلك من خلال زيادة مساحة سيطرتها على الأراضي في العمق السوري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبناء على ذلك، استباحت إسرائيل منطقة بطول 15 كم تمتد من ريف درعا الغربي وصولًا إلى ريف القنيطرة الشمالي.
وأشار أبو شريفة إلى أن إسرائيل تفرض واقعًا جديدًا يقوم على سيطرة أمنية بعمق 65 كم وصولًا إلى دمشق ومحيطها، إضافةً إلى إبقاء قواتها في مرتفعات جبل الشيخ والتلال المحيطة، والتي تعد من أبرز المناطق الاستراتيجية العسكرية في سوريا.
مشروع إقليمي
يرى الباحث السياسي غسان يوسف وجود مشروع إسرائيلي متعلق بخلق مناطق منزوعة السلاح في كل من سوريا ولبنان، عبر التوغل جنوبًا في العمق السوري، والوصول إلى نهر الليطاني في لبنان. وبناء على ذلك، يتم قضم أراضي البلدين تحت غطاء خلق مناطق منزعة السلاح، لافتًا إلى أن هذه التوغلات تؤدي إلى خلق واقع احتلال جديد، وعدم تقديم أي تنازل بخصوص الأراضي المحتلة سابقًا بما في ذلك الجولان.
ويشير يوسف إلى عدة عوامل تعزز من التوغلات الإسرائيلية في الداخل السوري، ومنها مسار الاتفاقيات الإبراهيمية بغطاء أميركي في المنطقة، وحالة الضعف العسكري للجيش السوري بعد تدمير مقدراته، وأخيرًا المناخ السياسي الجديد في العلاقات بين دمشق وإسرائيل.
أزمة ثقة
ويشير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو شريفة إلى أن إسرائيل ليس لديها ثقة أمنية بسوريا، وتشكو من قلق تجاه مصيرها الوجودي وسط بيئة ملتهبة، وهذا من أبرز الأسباب التي تدفعها إلى استثمار أعمالها العسكرية لفرض جملة من الشروط تلبي مصالحها في المنطقة، لا سيما أنها أعلنت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلق ملامح جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، يرى الكاتب غسان يوسف أن الثقة ليست موجودة حتى من قبل الحكومة السورية تجاه إسرائيل، إذ إن التطمينات الأمنية، والتهدئة لا تعني الثقة بالجانب الإسرائيلي، خاصةً أنها تستغل كافة الفرص للتوغل، وتحقيق أجندة توسعية داخل الأراضي السورية، كما هو الحال في لبنان وغزة والضفة الغربية والأردن.
قلق أردني
تعكس تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوب سوريا، قلقًا أردنيًا من هذه التوغلات التي اعتبرها الصفدي اعتداءً على الأردن، وهو ما يعكس، وفق الكاتب السياسي أبو شريفة، مخاوف متعلقة بالسيطرة على منابع المياه في حوض اليرموك، وما لذلك من أثر سلبي على حصة الأردن المائية التي تعاني بالأصل من الشح فيها.
ولفت أبو شريفة إلى وجود مخاوف أردنية متعلقة بإثارة البلبلة في الجنوب، بما في ذلك درعا، ومحافظة السويداء، من خلال التوغل البري، وإعلان إسرائيل بشكل متكرر تقديم الدعم للمكون الدرزي، وما لذلك من مخاطر انفصالية محتملة.
——————————
==========================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 25 أيار 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
———————————-
قسد في ساعتها الأخيرة/ صبا ياسر مدور
الأحد 2025/05/25
يتصافح الزعيمان، الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، أمس في إسطنبول، في زيارة غير متوقعة لكنها مفصلية. جاءت لتعنون الحل وتحسم الملف الأكثر حساسية في العلاقات الثنائية، ألا وهو ملف قوات سوريا الديمقراطية، “قسد”، محور الأجندة السورية – التركية المشتركة في الوقت الراهن. فلا يوجد ما هو أهم أو أكثر إلحاحاً بالنسبة لأمن سوريا وتركيا. ورغم أن الزيارة لم تكن مدرجة على أي جدول رسمي، إلا أنها جاءت في لحظة محسوبة بدقة، بعد ساعات فقط من الإعلان الأميركي عن إعفاء سوريا وقيادتها من العقوبات، وبعد أن اكتملت ظروف التفاهمات الأمنية والسياسية خلف الكواليس. ومعها، دخل ملف قسد مرحلة النضج ضمن إطار تفاهمي وتوافقي تركي- سوري- أميركي لم يتبق فيه سوى ضبط التفاصيل النهائية، حسب رؤية سورية- تركية.
بالنسبة لأنقرة، فإن إنهاء تهديد قسد لم يعد مجرد ملف أمن قومي طال أمده، بقدر ما هو مفتاح لمشهد سياسي جديد يُمهد لما يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان من تعديلات دستورية، قد تعيد رسم معادلة الحكم في تركيا لسنوات مقبلة. تتقاطع هذه المصالح مع اعتبارات تركية أخرى تتعلق بتركيز علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة ومحاولة تفعيل مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ظلت مسألة قسد إحدى العقبات المركزية، حتى وإن بدت تركيا في الظاهر غير مهتمة. لكن الأهم من ذلك، هو ما يمثله هذا الملف لتركيا كفرصة استراتيجية للتخلص من واحدة من أبرز نقاط ضعفها الإقليمية، ولم يكن ذلك ممكنا لولا التقارب الأميركي- التركي الذي كان واحداً من إعدادات الضبط الجديدة في المنطقة.
بالنسبة لسوريا، فقد ظل ملف سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مطلباً أولوياً من قوى ثورية وشعبية طالبت الإدارة الجديدة بحسمه عسكرياً، لا سيما بعد سقوط النظام. إذ ارتبطت قسد تاريخياً بمواقف إشكالية خلال الثورة، وبقيت على مسافة متوترة من فصائل المعارضة، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة. إلا أن إدارة الرئيس أحمد الشرع اختارت تأجيل الحسم، انطلاقاً من قناعة بأن الحل ليس سورياً فحسب، بل إقليمياً شاملاً ولمرة واحدة. كما أن الوصول إلى هذا المبلغ يقتضي تجريد قسد من أبرز أوراقها الضاغطة، وعلى رأسها ملف سجون داعش، الذي كانت تمسك به كوسيلة تفاوض مع الغرب، وورقة ضغط على الولايات المتحدة.
إلى أن جاء انتزاع هذه الورقة في التوافق الأميركي السوري التاريخي، الذي شمل تولي الإدارة السورية مسؤولية معتقلات داعش، في اللقاء التاريخي بين ترامب والشرع في الرياض، ذاك الذي ختم على اعتماد منهجية التعامل مع قسد وفق نمط التسوية لا التفاوض. وهذه هي المنهجية التي تسعى من خلالها دمشق فرض خط أحمر حاد تجاه أي مسعى للامركزية أو الفيدرالية. حيث بوجوده لا يخص قسد فحسب، بل يعد مبدأ ناظماً أرادت دمشق تحصيله وتكريسه في هذا الملف، ليمتد إلى مناطق أخرى مثل السويداء والساحل، حيث ظهرت دعوات للحكم الذاتي أو الفيدرالية. إذ يدرك الشرع أن أي تنازل في هذا الملف قد يجر لاحقاً تنازلات أكبر في ملفات أخرى كالسويداء.
ضمن هذا السياق، يمكن تحديد ثلاثة سياقات تدفع بمسألة قسد نحو ترتيبات شبه نهائية، تتبلور مع لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وأحمد الشرع، وما سيعقبه من خطوات تنفيذية في شمال شرق سوريا.
أول هذه المسارات، التحول التاريخي في الصراع التركي- الكردي، الذي انعكس بشكل مباشر على وزن قسد ووظيفتها السياسية والعسكرية. فقد شكل إعلان عبد الله أوجلان وقف العمل المسلح في حزب العمال الكردستاني منعطفاً استراتيجياً، مهد لإبرام اتفاق أولي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي في شهر رمضان الماضي، وتوج لاحقاً بإعلان حل الحزب، ما وفر انكشافاً سياسياً وقانونياً لسحب الشرعية من كافة امتدادات الحزب، بالأخص داخل سوريا.
الاتفاق بين الشرع وعبدي يمثل المسار الثاني الذي شكل الإطار السوري- الكردي، تضمن في ظاهره تأكيداً على حقوق المواطنة الكاملة للأكراد في سوريا، لكنه ارتكز فعلياً على ركيزتين بالغتي الحساسية: رفض مبدأ التقسيم، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية الخاضعة لسيطرة قسد ضمن بنية الدولة السورية. ورغم الحديث عن الدمج، فقد ترك الاتفاق عمداً هامشاً من الغموض البناء في تفسيرات تتراوح بين ما إذا كان سيتم اندماجه ككيان موحد أو كأفراد موزعين ضمن وحدات الجيش. وهنا تبرز خصوصية حضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في قمة إسطنبول، لوضع خطوط دقيقة، ربما تهدف عدم قيام أي بنية عسكرية كردية ضمن ضمن الجيش السوري، بما يبدد الهواجس التركية ويمنع إعادة إنتاج انقسام مؤسسي في المستقبل.
المسار الثالث في التقارب التركي- الأميركي الذي وفر لتركيا مظلة سياسية مريحة في إدارة ملف قسد. إذ بدا واضحاً أن الرئيس دونالد ترامب يتعامل مع الملف السوري من زاوية رؤية تركية- سعودية منسقة، تقدم الاستقرار الإقليمي كأولوية على حساب مشاريع الانفصال أو الإدارة الذاتية. وقد برز هذا بتعيين توماس باراك، مبعوثاً أميركياً لسوريا، وهو الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في أنقرة، في إشارة إلى اصطفاف واشنطن عملياً مع مقاربة أنقرة إزاء ملف شمال شرق سوريا عموماً.
وبتكامل عوامل الدفع الإقليمية والدولية، يبدو أن ملف قسد قد دخل ساعته الأخيرة، لا بالحسم العسكري، بل ربما من خلال إعادة تسوية تاريخية قد تمنح الأكراد السوريين حقوقهم الدستورية الكاملة، بما في ذلك الاعتراف بهويتهم وحقوقهم الثقافية والسياسية، تحت سقف المواطنة المتساوية، يعكس روح الاتفاق بين الرئيس الشرع- مظلوم عبدي، وعلى نحو يوازي نموذج الاندماج الذي طورته تركيا داخلياً مع المكون الكردي لديها. لكن يبقى غير واضح آلية نزع السلاح وتفكيك بنية قسد القتالية والتعامل معها، في ظل ما تمتلكه من خبرات ميدانية وتدريب متقدم على يد القوات الأميركية. بالإضافة لمسألة إشكالية أخرى تتعلق بمصير المقاتلين الأكراد من أصول تركية المنضوين في صفوف قسد، وما إذا كانوا سيُدمجون ضمن وحدات الجيش السوري مع منحهم الجنسية السورية، أم سيعادون إلى تركيا في إطار تفاهمات أمنية ثلاثية تشمل أنقرة، دمشق، وحزب العمال الكردستاني قبل حله.
في المجمل، أيا يكن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه التسوية، فإنها تحول دراماتيكي في المسألة الكردية داخل سوريا، ومقاربة جديدة لقضايا الأقليات في المنطقة، لا تعيد إنتاج نموذج كردستان العراق
المدن
——————————–
ما بين اللامركزية والفيدرالية في سورية/ مالك الحافظ
الأحد، ٢٥ مايو / أيار ٢٠٢٥
يختلط، في النقاشات السورية التي تلت سقوط نظام الأسد، الحديث عن الفيدرالية واللامركزية، كما لو أنهما مصطلحان مترادفان. تارّة تُتهم الفيدرالية بأنها مشروع تقسيم، وتارّة يُقارب الحديث عن اللامركزية كما لو أنه مجاز لغوي للفيدرالية، ما يجعل من أي دعوة إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المركز والأطراف تهمة مسبقة بالانفصال. في الحالتين، يبدو أن المشكلة لا تكمن في المفاهيم نفسها، بل في السياق السياسي المُحمّل بالتوجّس، وفي ذاكرة السوريين التي لم تعرف من السلطة إلا شكلها المركزي الصارم. ولكن قبل أن نمضي في التقييم، من المفيد أن نفصل بين المفهومين، في جوهر علاقتهما بطبيعة الدولة، وبالسلطة، وبالهوية الوطنية.
اللامركزية، من حيث التعريف العملي، هي توزيع جزئي للصلاحيات داخل الدولة الواحدة، بحيث تبقى السيادة موحّدة، ولكن تُمنح الوحدات الإدارية (بلديات، محافظات، مجالس محلية) القدرة على اتخاذ قرارات في قطاعات محدّدة كالصحة، والتعليم، والخدمات. أما الفيدرالية، فهي نظام سياسي دستوري أكثر تعقيداً، تُوزّع فيه السيادة بين الحكومة المركزية والكيانات الفيدرالية، وتتمتع هذه الكيانات بدستور أو قوانين خاصة، أحياناً ببرلمان، وقوة أمنية، وقواعد مالية خاصة بها. والفرق هنا جذري، فالفيدرالية تعني أن الدولة مكوّنة من “وحدات سياسية” متمايزة، ولكنها متّحدة. أما اللامركزية فهي مجرّد إعادة توزيع للوظائف داخل بنية دولة موحّدة لا تتغيّر طبيعتها القانونية.
كل محاولةٍ في سورية لطرح الفيدرالية تُقابل برفضٍ مسبق. ليس فقط لأن الفكرة مرتبطة في أذهان كثيرين بمشروع انفصال، لكن الخطاب الوطني نفسه بُني تاريخياً على مركزية الدولة بوصفها خط الدفاع الأول ضد أي محاولةٍ للتجزئة. ما يجعل من كلمة “الفيدرالية” ثقيلة في الوعي السياسي السوري، حتى قبل أن تُفهم بتفاصيلها.
السؤال في سورية اليوم ليس كيف نمنع التقسيم، وإنما كيف نُنظّم واقعاً منقسماً أصلاً، ضمن عقد سياسي واضح، يضمن بقاء البلاد ضمن وحدة سياسية مع الاعتراف العملي بتعدّد مراكز القرار.
ينبّهنا ديفيد هيلد، في قراءته لتحوّلات الدولة الحديثة، إلى أن المركزية الصلبة التي نشأت في القرن العشرين لم تعُد صالحة لعالم تعدديّ. إذ لم تَعُد السيادة تعني الاحتكار الكامل للقرار، وإنما القدرة على التنسيق بين مستويات السلطة المختلفة، بشرط المساءلة والشفافية. هذا تماماً ما تفتقده سورية، وهذا ما يجعل من اللامركزية اليوم شرطاً للتماسك.
في التجربة الألمانية، لم تنتج الفيدرالية انقساماً، بل رسّخت التمثيل السياسي والاجتماعي على مستوى الولايات، وأوجدت نمطاً من “التنافس العادل” في تقديم الخدمات والتنمية. وفي العراق، رغم هشاشة الوضع الأمني، خفّف الاعتراف بكيانات متعدّدة (كردستان العراق نموذجاً) ضمن الدولة العراقية من حدّة المطالب الانفصالية. أما في لبنان، الذي لم يعلن يوماً عن كونه دولة فيدرالية، فغياب نظام لا مركزي حقيقي أو فيدرالي، جعل كل طائفةٍ تدير شؤونها عملياً خارج الدولة، ما ساهم في تآكل فكرة المواطنة الجامعة.
العقل المركزي الذي ورثه الجميع من زمن الأسد ما زال يحكم الخيال السياسي
رغم أن اللامركزية تُطرح اليوم وكأنها ابتكار حديث أو استجابة استثنائية لما بعد النزاعات، إلا أن جذورها تعود في التاريخ السوري إلى بدايات القرن العشرين. ففي 1922، وفي ظل الانتداب الفرنسي، طُرحت صيغة “الاتحاد السوري” بكونها ترتيبا إداريا ضمّ ثلاث وحدات: دمشق، حلب، والساحل. ورغم أن السياق كان استعمارياً ومشحوناً بنيات التقسيم، أشار هذا النموذج، ولو بشكل أولي ومشوَّه، إلى إمكانية إدارة الدولة بصيغٍ لا مركزية تمنح المحليات هامشاً من الصلاحيات. لكن المهم هنا ليس النموذج الذي فرضته سلطة احتلال، بل النقاشات التي أُثيرت في تلك المرحلة بشأن توزيع السلطات بين المركز والمحيط. فقد شهدت تلك اللحظة، على هشاشتها، ولادة تخيُّل سياسي في سورية عن إمكانات الحكم المحلي وتعدّد مستويات السلطة، وهو تخيُّل لم يُستكمل لاحقاً، لكنه ظلّ يلوح احتمالا مؤجّلا في ذاكرة التجربة السورية.
يذكّرنا الفقيه الدستوري الفرنسي، موريس دوفرجيه، بأن اللامركزية ليست نصّاً قانونياً، بل علاقة ثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وهذه العلاقة لم تنشأ في سورية في غالب المراحل، فظلّ التوجّس من المجتمعات المحلية أقوى من الرغبة في منحها إدارة شؤونها.
لا يكفي الحديث في سورية اليوم عن الفيدرالية بوصفها إعلاناً سياسياً، ولا عن الوحدة بوصفها قدراً مقدّساً. المطلوب إعادة تفكير جذرية في شكل الحكم، تُبنى على إدراك لتعدّد البنى الاجتماعية والثقافية، ولتفكك السلطة المركزية السابقة من دون قيام بديل شرعي متماسك. في هذا الفراغ، لا يمكن الركون إلى جهاز بيروقراطي مترهّل، ولا إلى مركزٍ يمسك الصلاحيات بلا أدوات فعالة. وحدها مقاربة عادلة وواقعية لإعادة توزيع السلطة يمكن أن تمنح السوريين فرصة لبناء دولة قابلة للحياة. ولا يزال ما طرحه بيير روسانفالون قبل عقدين عن “الدولة العادلة” صالحاً تماماً للسياق السوري، فالعدالة الإدارية شرط للثقة السياسية، وأي نظام لا يُعيد توزيع السلطة يصبح مع الوقت أداةً لتعميق الانقسام، ولو لم يكن يقصده.
المطالبة بالفيدرالية لا تعني بالضرورة رفضاً للوحدة، كما أن عدم الثقة بالمركز ليس جريمة سياسية. ثمّة من يرى في الفيدرالية وسيلة لحماية خصوصيته، وثمّة من يراها أفقاً لتحقيق مواطنة أكثر توازناً وعدلاً. وفي الحالتين، أي صيغة حكم عادلة يجب أن تُبنى عبر تفاهم وتفاوض يعترف بأن السيادة عقد اجتماعي متجدد، لا امتيازاً مغلقاً في يد سلطة واحدة. وسواء سميناها فيدرالية، أو لامركزية موسّعة، أو عقداً إدارياً جديداً، يتركّز جوهر النقاش اليوم حول استعداد السوريين لاقتسام السلطة بشكل عادل، أم أن العقل المركزي الذي ورثه الجميع من زمن الأسد ما زال يحكم الخيال السياسي.
لا يكفي الحديث في سورية اليوم عن الفيدرالية بوصفها إعلاناً سياسياً، ولا عن الوحدة بوصفها قدراً مقدّساً
في الظروف الحالية التي تعيشها سورية، لا توجد هيئة دستورية منتخبة أو مجلس تأسيسي يمتلك الشرعية الكاملة لصياغة شكل نظام الحكم الجديد، لكن هذا لا يعني أن الخيار بين الفيدرالية أو اللامركزية يجب أن يُحسم بتفاهمات فوقية أو ميزان قوى مؤقت. تقتضي المرحلة الانتقالية تأسيس مسار سياسي واضح نحو عقد اجتماعي جديد، يبدأ بتشكيل هيئة تأسيسية ذات شرعية تمثيلية نسبية على الأقل، تُبنى من خلال عملية تشاورية موسّعة بين قوى المجتمع المدني، والمكوّنات المحلية، والمجالس المنتخبة أو شبه المنتخبة إن وجدت، وبإشرافٍ أممي أو جهاتٍ ضامنة للانتقال. وهذه الهيئة، وإن لم تكن “منتخبة بالكامل” في المعنى الدستوري التقليدي، إلا أنها يجب أن تستمدّ شرعيتها من توازن واقعي وتوافقي، ومهمّتها الأساس صياغة مسودة دستور انتقالي أو دائم، يُطرح لاحقاً للاستفتاء الشعبي، ويحدّد فيه شكل الدولة، نمط الحكم، وقواعد تقاسم الصلاحيات.
… يجب أن يُبنى اختيار الفيدرالية أو اللامركزية على قراءة دقيقة لبنية الدولة والمجتمع، لتوزّع السكان، ولطبيعة الموارد، ولتجارب العيش المشترك في الماضي القريب. الفيدرالية، حين تُبنى على التوافق، قد توفّر استقراراً ذاتياً لوحدات جغرافية أو ثقافية تشعر بالتهميش أو القلق، وتشيع شعوراً بالانتماء الطوعي للدولة الجامعة. أما اللامركزية الإدارية، فإنها تمنح المجتمعات المحلية القدرة على إدارة شؤونها اليومية من دون المساس بالبنية السيادية للدولة، وتُعدّ أداة مرنة لإعادة التوازن بين المركز والأطراف.
في ظل سلطةٍ انتقاليةٍ هشّة، وبلد أنهكته المركزية العنيفة عقوداً، تبدو الحاجة ماسّة إلى فتح نقاش هادئ حول الخيارين، بوصفهما أدوات سياسية وإدارية يمكن أن تساهم في إنتاج عقد وطني جديد يُراعي التعدّد، ويعيد توزيع الثقة، ويجعل من الدولة حاضنة. الشكل النهائي يجب أن يُتوافق عليه عبر عملية تشاركية واسعة، ويُقرّ عبر دستور حيٍّ يكتبه السوريون بأيديهم، لا يُنسخ عن تجارب الآخرين، ولا يُصاغ لإرضاء قادة المرحلة الانتقالية.
العربي الجديد
———————
العلاقة بين “قسد” ودمشق تتأرجح بين خيارين/ محمد أمين و سلام حسن
24 مايو 2025
لا تبدو العلاقة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، سلطة الأمر الواقع في شمال شرق البلاد، في أفضل حالاتها. فالتقدم في تنفيذ مضامين الاتفاق الذي وقّعته “قسد” ودمشق في مارس/آذار الماضي لا يزال دون مستوى توقعات وآمال السوريين. ويبدو الطرفان اليوم أمام خيارين ربما لا ثالث لهما، الأول: المضي قدماً في تطبيق الاتفاق الذي نص على دمج “قسد” في المنظومة العسكرية للبلاد، ما يعني فرض الدولة سيطرتها على كامل الشمال الشرقي من البلاد، والثاني الصدام العسكري الذي يحاول الطرفان تجنّبه كيلا تنزلق المنطقة إلى حالة اقتتال ربما تخرج عن نطاق السيطرة.
وشرعت “قسد” قبل أيام في حملة اعتقالات طاولت ناشطين في محافظة الرقة بحجة “التواصل مع الحكومة السورية”، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة حفر الأنفاق في مدينة الرقة، ما دفع ناشطين إلى إطلاق حملة عبر وسائل التواصل لإيقاف عمليات الحفر كونها تشكل خطراً على مباني هذه المدينة التي دمر التحالف الدولي أغلبها قبل سنوات. وتشي هذه الأنفاق بأن “قسد” ليست بصدد تسليم المنطقة للجيش السوري كما نصّ الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي في مارس الماضي، وهو ما يبرر الاستعداد العسكري لمواجهة محتملة مع الجيش السوري.
ويضغط الشارع في الشمال الشرقي من البلاد على الإدارة السورية الجديدة من أجل حسم مصير مناطقهم، بيد أن هذه الإدارة تحاول -كما يبدو- تغليب الخيار السياسي على العسكري لتجنيب البلاد دورات عنف جديدة. ويبدو أن الجانب التركي يدفع باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق وحسم مصير الشمال الشرقي من سورية، فأنقرة تعتبر وجود “قسد” التي تشكل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي خطراً على أمنها القومي.
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأناضول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أجرى، الاثنين الماضي، مباحثات مع الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات حسين السلامة. وبحسب الوكالة، “ناقش اللقاء مسألة دمج عناصر تنظيم ‘بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) / واي بي جي (الوحدات الكردية)’ على غرار المجموعات الأخرى في سورية بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر داعش إلى الحكومة السورية”.
ويرفض الجانب التركي أي شكل من أشكال السيطرة لقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي من سورية. وكانت تركيا شنت عمليات عسكرية واسعة النطاق على “قسد”، برية وجوية، طيلة السنوات الماضية. وتزايدت المخاوف لدى سكان الشمال الشرقي من سورية من لجوء عدد من مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى مناطقهم بعد حل هذا الحزب في تركيا وشروعه في تسليم سلاحه وإنهاء “الكفاح المسلّح” هناك، ما من شأنه دفع المشهد إلى مزيد من التعقيد.
غموض يلف مصير العلاقات بين “قسد” ودمشق
ورأى جان علي، وهو كاتب مقيم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، في حديث مع “العربي الجديد”، أن غموضاً يلف مصير العلاقات بين “قسد” ودمشق، معرباً عن اعتقاده أن هناك سيناريوهات عدة ربما تحكم العلاقة بين الطرفين منها “الصدام العسكري، ما يعني نسف كل الاتفاقيات السابقة بينهما”. وقال: “هناك سيناريو السير بالاتفاقيات وحلحلة عقد الملفات والقضايا العالقة حتى اللحظة، من خلال المضي بأعمال اللجان المشكلة المتخصصة بين الفريقين وحل الإشكاليات كافة نهاية السنة الجارية كما نص الاتفاق”. كما أن هناك سيناريو ثالثاً وهو “وقوع مواجهات عسكرية محدودة تمكن السيطرة عليها”. وبرأيه، فإن الصدام العسكري، في حال وقوعه، “ربما يجد جهات إقليمية ودولية تؤججه مثل إيران، وربما روسيا إلى حد ما وبعض القوى الفاعلة عسكرياً في العراق”، مضيفاً: المليشيات الموالية لإيران لها نفوذ في العراق وتنتشر على الحدود السورية العراقية.
من جهته، قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن الحوار “مع حكومة دمشق مستمر في ما يخص ملف عودة مهجرّي عفرين ورأس العين وتل أبيض”، مشيراً إلى أن “العمل مستمر بخصوص تشكيل وفد يمثل الرؤية الكردية”، مضيفاً: في الأيام القليلة المقبلة، ستبدأ هذه اللجنة المشكلة عملها للتحاور مع دمشق.
تحذير من “حرب أهلية”
وفي تصريحات أخرى، قال خليل، لفضائية “كردسات نيوز”، إن “إصرار الحكومة السورية على المركزية سيقسم سورية ويقود إلى الحرب الأهلية”. وأضاف أن جدول أعمال وفد “الإدارة الذاتية” للتفاوض مع دمشق يتضمن “تعديل دستور سورية والتوافق عليه وعلى نظام الحكم في البلاد والجيش والاعتراف بالقضية الكردية”. وقال: “لا نقبل بسياسات النظام الحالي تجاه العلويين والدروز، والوفد سيناقش حقوق المكونات السورية من دون تهميش”.
وأضاف أن ما وصفه بـ”التحريض الإعلامي من قبل السلطات السورية ضد قسد والإدارة الذاتية غير مقبول ومخالف للاتفاقيات”، مشيراً إلى انفتاح “الإدارة الذاتية” على الحوار لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية مع حكومة الشرع. وأوضح أن “قوات قسد ووحدات الحماية ليست امتداداً لحزب العمال الكردستاني، وأن مستقبلها يناقش مع دمشق، ولا نقبل بإملاءات تركيا بصدد نزع سلاحنا”، مضيفاً أن التحالف الدولي والإدارة الأميركية “لم تخطر الإدارة الذاتية وقسد حيال تسليم ملف تنظيم داعش للحكومة السورية”، معتبراً أن “إدارة ملف داعش من دون قسد غير ممكن، والغرب يعلم العواقب، نظراً إلى وجود معادلة عدم ثقة بقدرات دمشق ووجود فصائل ضمن الحكومة السورية كانت بالأمس داعش”.
وفي السياق نفسه، قال محمود حبيب، المتحدث الرسمي باسم فصيل “قوات الشمال” المنضوي في “قسد”، لـ”العربي الجديد”: “نذكّر دائماً بالطرح الوطني الذي يتبنّى الحوار على أرضية متساوية من دون إقصاء، ونأمل أن يكون بناء الوطن والمواطن أولوية لدى الجميع حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة”.
وعُقدت عدة جولات تفاوضية بين “قسد” والحكومة السورية لتنفيذ اتفاق مارس الماضي، حققت بعض التقدم في ملف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وملف سد تشرين على نهر الفرات شمال شرقي محافظة حلب. ولكن لم تشهد بقية الملفات أي تقدّم معلن، حيث لم تتسلم الحكومة حقول وآبار نفط وغاز في مناطق سيطرة “قسد” رغم بدء انسحاب قوات التحالف من أهم حقلين في ريف دير الزور الشرقي وهما العمر وكونيكو. كما لم يشهد ملف السجون التي تضم آلاف المسلحين المنتمين لتنظيم داعش أي حلحلة، رغم أن الإدارة الأميركية طلبت رسمياً من دمشق تولي هذا الملف. ولم تُحل عقدة ملف التعليم و”الإدارة الذاتية” الكردية، ما يدفع للاعتقاد أن تطبيق اتفاق مارس سيواجه الكثير من المعوّقات، لا سيما أن القوى السياسية الكردية توافقت على وثيقة تضم مجموعة مطالب تُعد بنظر دمشق غير واقعية وغير قابلة للتطبيق كونها تشرّع الباب أمام تشظّي البلاد على أسس عرقية وطائفية.
العربي الجديد
———————————-
إلقاء السلاح.. تأثيرات على الحكومة السورية مع “قسد”/ عبد اللطيف نايف البصري
2025.05.23
شهدت الساحة السورية تطوراً لافتاً في الأيام القليلة الماضية مع إعلان حزب العمال الكردستاني قراره التاريخي بحل نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك صراعاً مسلحاً استمر لأربعة عقود. يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، بعد شهرين فقط من توقيع اتفاقية بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا.
خلفية قرار حزب العمال الكردستاني
أعلن حزب العمال الكردستاني في 12 من مايو/أيار 2025 قراره بحل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا، وذلك في ختام مؤتمره الثاني عشر. وقد أوضحت وكالة “فرات” المقربة من الحزب أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء “الكفاح المسلح” وجميع الأنشطة التي تتم باسمه، معتبراً أنه “أنجز مهمته التاريخية”.
وعند تأمل هذا القرار، أجد أنه يمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في فكر الحركة الكردية المسلحة التي طالما آمنت بأن السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبها.
فالحزب الذي قاد تمرداً استمر لأربعين عاماً، يقر الآن بأن “الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية”، وهو ما يعكس تحولاً نحو العمل السياسي بدلاً من المسلح.
العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقسد
تتسم العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالتعقيد والتداخل التنظيمي. فرغم نفي قيادة قسد وجود علاقات رسمية مع الحزب، إلا أن مصادر متعددة تؤكد وجود ارتباط أيديولوجي وتنظيمي بينهما.
وكشفت مصادر خاصة أن الكوادر القيادية في قسد تتلقى توجيهاتها من شخصية تُعرف بلقب “الدكتور”، وهي غير سورية تقيم في جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني.
كما أن غالبية المقاتلين الأجانب في قسد سيغادرون الأراضي السورية بعد إعلان حل الحزب، حيث خرج عدد كبير منهم بالفعل.
وفي تقديري، فإن هذا التداخل التنظيمي يجعل من الصعب فصل مصير قسد عن قرار حزب العمال الكردستاني، رغم محاولات قيادة قسد التنصل من هذا القرار والتأكيد على استقلاليتها. فالجذور الفكرية والتنظيمية المشتركة تجعل من المستبعد أن يكون قرار الحزب بمعزل عن مستقبل قسد في سوريا.
الاتفاقية بين الدولة السورية وقسد
في 10 من مارس/آذار 2025، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
تضمنت الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية، أبرزها:
• ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
• الاعتراف بالمجتمع الكردي كمجتمع أصيل في الدولة السورية.
• وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.
• دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية.
• ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم.
وأرى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو إعادة توحيد الأراضي السورية وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. لكن نجاحها يظل مرهوناً بمدى التزام الطرفين بتنفيذ بنودها، وبالتطورات الإقليمية المتسارعة، ومنها قرار حزب العمال الكردستاني.
يعزز قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح موقف الحكومة السورية في مفاوضاتها مع قسد.
تأثير قرار العمال الكردستاني على الساحة السورية
التأثير السياسي
يعزز قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح موقف الحكومة السورية في مفاوضاتها مع قسد، إذ يضعف الموقف التفاوضي للأخيرة التي كانت تستمد قوتها جزئياً من علاقتها غير المعلنة مع الحزب. كما يفتح الباب أمام تسريع تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدمج المؤسسات العسكرية.
وفي رأيي، فإن هذا التطور قد يدفع قسد إلى تقديم تنازلات إضافية للحكومة السورية، سعياً للحفاظ على مكتسباتها في ظل تراجع دعمها الإقليمي. كما أنه يعزز فرص نجاح المسار السياسي السوري، شريطة أن تستثمر دمشق هذه الفرصة بحكمة، وأن تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية بحسن نية.
التأثير الأمني
من الناحية الأمنية، يمكن أن يسهم قرار الحزب في تحسين الوضع الأمني في شمالي سوريا، خاصة مع توقعات مغادرة المقاتلين الأجانب للأراضي السورية. كما أنه قد يقلل من حدة التوتر بين تركيا وقسد، مما يخفف الضغط العسكري التركي على الحدود السورية الشمالية.
لكنني أرى أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال ظهور خلافات داخل صفوف قسد حول كيفية التعامل مع هذا المتغير الجديد، مما قد يؤدي إلى انشقاقات أو صراعات داخلية تهدد استقرار المناطق التي تسيطر عليها. كما أن هناك تساؤلات حول مصير الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة عناصر الحزب في سوريا.
التأثير الاقتصادي
اقتصادياً، يمهد قرار الحزب الطريق أمام تنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بدمج حقول النفط والغاز ضمن إدارة الدولة السورية، مما قد يعزز موارد الدولة ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأعتقد أن عودة السيطرة على الموارد الطبيعية في شمال شرقي سوريا إلى الدولة المركزية ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري ككل، شريطة أن يتم استثمار هذه الموارد بشكل عادل يضمن تنمية المناطق المتضررة من الصراع.
خاتمة
يمثل قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح وحل نفسه نقطة تحول محورية في المشهد السوري، إذ يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأوراق في الشمال السوري، ويعزز فرص نجاح الاتفاقية بين الدولة السورية وقسد. لكن تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، وتجاوز عقود من الصراع والانقسام.
وفي النهاية، أرى أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة السوريين على بناء دولة تتسع للجميع، تحترم التنوع وتضمن الحقوق، وتنبذ العنف كوسيلة لتحقيق المطالب السياسية. فالتحول من لغة السلاح إلى لغة السياسة هو الطريق الوحيد نحو سوريا مستقرة وموحدة.
تلفزيون سوريا
————————————
فدرالية قسد بين سندان التاريخ ومطرقة الدستور/ محمد رجب
24/5/2025
في خضم المشهد السوريّ المضطرب، تطرح قوات سوريا الديمقراطية (قسَد) رؤى متباينة حول مستقبل الحكم في الجزيرة السورية ذات الغالبية العربية، متأرجحة بين الفدرالية واللامركزية، دون إطار دستوري واضح يرسّخ هذه الأطروحات.
هذه التوجهات ليست وليدة مطالب شعبية خالصة، بل تتأثر بشكل مباشر بالتحولات السياسية الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعًا حول مدى توافق هذه الأطروحات مع السياقات الدستورية والتاريخية لتكوين الفدراليات.
التاريخ السياسي يُظهر أن التحول نحو الفدرالية لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان سياسي أو استجابة لتحولات خارجية، بل يجب أن يكون نابعًا من إرادة شعبية عبر دستور يوافق عليه المواطنون في انتخابات حرة
في الأنظمة السياسية، تتخذ الدول أحد الشكلين التاليين:
الدولة البسيطة، حيث توجد سلطة مركزية واحدة، قد تكون ذات إدارة مركزية كاملة أو لا مركزية إدارية، ما يسمح للمحافظات بإدارة بعض شؤونها دون استقلال سياسي.
الدولة المركبة، التي تنقسم إلى فدرالية وكونفدرالية، حيث الفدرالية تحتفظ بسيادة موحدة رغم توزيع السلطات، بينما الكونفدرالية تقوم على اتحاد كيانات شبه مستقلة تربطها اتفاقيات فضفاضة.
التاريخ السياسي يُظهر أن التحول نحو الفدرالية لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان سياسي أو استجابة لتحولات خارجية، بل يجب أن يكون نابعًا من إرادة شعبية عبر دستور يوافق عليه المواطنون في انتخابات حرة.
كل الدول الفدرالية في العالم نشأت عبر عمليات دستورية معقدة، ولم نشهد – إلا في حالة العراق- تحولًا مباشرًا إلى دولة فدرالية من إقليمين، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى شرعية الأطروحات التي تقدمها بعض القوى الطارئة في سوريا.
ويُنظر إلى الفدرالية العراقية كنموذج مشوّه، نظرًا لعدة عوامل تتناقض مع المعايير الفدرالية المتعارف عليها، منها:
غياب التوزيع المتوازن للسلطة: على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 نصّ على الفدرالية، فإن تطبيقها الفعلي كان غير متوازن، حيث يتمتع إقليم كردستان بسلطات واسعة، بينما لم تحظَ المحافظات الأخرى بنفس الصلاحيات، ما أدى إلى اختلال واضح في توزيع السلطة.
التداخل بين السلطات الإقليمية والمركزية: فالفدرالية الصحيحة تتطلب وضوحًا في الفصل بين السلطات، بينما في العراق هناك تنازع مستمر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قضايا مثل تصدير النفط، وصلاحيات الجيش، والسياسة الخارجية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.
عدم وجود رقابة دستورية فاعلة: فعلى الرغم وجود نصوص في الدستور العراقي تحدد آليات الفدرالية، فإن التطبيق العملي غالبًا ما يخضع للمصالح السياسية، حيث تتجاوز بعض الكيانات الإقليمية صلاحياتها دون محاسبة حقيقية، ما يحوّل الفدرالية إلى أداة سياسية بدلًا من كونها نظامًا حكوميًّا راسخًا.
التقسيم الطائفي والمناطقي: الفدرالية العراقية لم تنشأ على أساس هيكلي إداري واضح، بل جاءت ضمن بيئة سياسية مشحونة بانقسامات طائفية وعرقية، حيث أصبحت الفدرالية أداة تُستخدم لتعزيز نفوذ بعض القوى، بدلًا من كونها نظامًا يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وهذا ما تمضي إليه قسد.
إن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ
ومن الأمثلة البارزة على هذه التشوهات استمرار الصراع بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية، وعدم قدرة السلطة المركزية على فرض سيادة واضحة على كامل الأراضي العراقية، ما يجعل الفدرالية العراقية أقرب إلى كونها حالة استثنائية غير مكتملة، لا نموذجًا يمكن الاستناد إليه في تجارب أخرى.
واليوم، بينما تطالب قسد بالفدرالية تارةً وباللامركزية تارةً أخرى، فإن الواقع السياسي يُظهر أن هذه الأطروحات لا تستند إلى إرادة شعبية واضحة، بل تخضع لتبدلات في السياسات الدولية وتجاذبات، خاصة مع تغير مواقف الولايات المتحدة.
أما من الناحية الدستورية، فلا يمكن لأي كيان سياسي -فضلًا عن العسكري- أن يحدد مستقبل سوريا دون وجود دولة جامعة، تحترم الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، الذين سيصوتون على دستور يحدد شكل بلدهم ونظامه السياسي.
إن للسياسة الخارجية دورًا كبيرًا في تحديد معالم المشهد السوري، حيث تفرض القوى الإقليمية والدولية استقطابات حادة، تؤثر على مصير السوريين أكثر من أي عملية داخلية فعلية.
وفي هذا السياق، فإن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ.
ومن الجدير بالذكر أن سوريا اليوم ليست أمام صراع سياسي على الصعيد الداخلي، بل أمام مرحلة حاسمة لبناء وطن يحفظ كرامة المواطن قبل أي اعتبارات أخرى؛ حيث لا يمكن تقرير مستقبل البلاد وفق مصالح مرحلية أو استجابة لضغوط خارجية، بل يجب أن يكون بناء الدولة هو الهدف الأول، بحيث يتاح للسوريين الاختيار الحر بين الفدرالية، أو الدولة البسيطة، أو أي نموذج آخر.
وينبغي التذكير أن الشرعية السياسية لا تُكتسب عبر السيطرة العسكرية أو التحالفات الخارجية، بل عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لذلك، لا يحق لأي طرف سياسي -مهما كان نفوذه- أن يفرض شكل الحكم على سوريا، دون وجود دستور واضح يعبّر عن إرادة جميع المواطنين.
بينما تطرح قسد نماذج سياسية متنوعة، فإن غياب الأساس الدستوري والاستقطابات الخارجية يجعل هذه الأطروحات تفتقر إلى المشروعية الكاملة.
سوريا اليوم بحاجة إلى مشروع وطني يضمن حقوق الجميع، ويمنح المواطنين القدرة على اختيار نظام الحكم الذي يعبر عن إرادتهم، ولا يكون مجرد استجابة لتوازنات سياسية مؤقتة أو ضغوط دولية.
فهل يحق للمواطن السوري أن يقرر مصير بلده بين الفدرالية وغيرها؟ أم إن “ديمقراطية” قسد لا تتماشى مع هذ الحق؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
ناشط سياسي، سوري
الجزيرة
—————————
كيف تخطط تركيا لتفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني؟/ زيد اسليم
23/5/2025
أنقرة- بينما يدخل صراع الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني منعطفا جديدا بدأت أنقرة الإعداد لمرحلة دقيقة تهدف إلى تفكيك البنية المسلحة للتنظيم ونزع سلاحه بالكامل.
وتدور في الأوساط السياسية والأمنية نقاشات موسعة بشأن آليات التنفيذ، وسط تسريبات عن خطة خماسية تقودها الاستخبارات الوطنية التركية، وتستلزم تنسيقا مع حكومتي الجوار في العراق وسوريا.
لكن نجاح هذه الخطة لا يبدو محسوما في ظل تعقيدات ميدانية واحتمالات لانشقاقات داخل التنظيم، فضلا عن تحديات ضبط السلاح والكوادر في بيئات خارجة عن السيطرة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية وآلية ضمان استدامتها.
خطة التفكيك
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا إن أنقرة تجري محادثات مع حكومتي بغداد وأربيل بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم خارج حدود تركيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستخدم أيضا استقرار العراق وسوريا خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام تركية، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين يرجح أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة في مواقع محددة داخل إقليم كردستان العراق.
وتشير المعلومات إلى أن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ستكون المحاور الأساسية للعملية، حيث تُخصَص نقاط تجمّع لتسليم السلاح بإشراف مباشر من الجهات المعنية.
وبموجب الترتيبات المقترحة، سيزود عناصر الحزب الجهات المختصة بإحداثيات دقيقة لمواقع تخزين الأسلحة والمخابئ الجبلية التي تضم الذخائر والمعدات تمهيدا لتفكيكها.
في المقابل، ستتولى السلطات الأمنية والعسكرية التدقيق في الأسلحة المسلّمة، ومقارنتها بقوائم الجرد التي أعدتها أجهزة الاستخبارات، للتأكد من عدم وجود أسلحة مخفية خارج نطاق العملية الرسمية.
ومن المتوقع أن يتولى جهاز الاستخبارات الوطني التركي الإشراف المباشر على تنفيذ خطة تفكيك البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع كل من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان.
ووفق ما أوردته صحيفة “تركيا” التركية، فإن من المنتظر أن تشارك القوات المسلحة التركية أيضا في هذه المرحلة، لضمان جمع الأسلحة وتأمينها ضمن آلية ميدانية مشتركة تشمل أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية شمالي العراق.
وتهدف هذه الترتيبات إلى إتمام عملية تسليم السلاح بشكل كامل بحلول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لانطلاق مرحلة سياسية جديدة في الداخل التركي.
وبحسب موقع “تي 24″ التركي، فإن سيتم استكمال الإجراءات الأمنية المرتبطة بتسليم الأسلحة قبل نهاية الصيف، ليصار بعدها إلى دعوة البرلمان لعقد جلسات خاصة تبحث ترتيبات المرحلة التالية لـ”إنهاء التمرد”.
وفي السياق، قال الباحث السياسي عمر أفشار في حديث للجزيرة نت إن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة قدرة تحقيق مستقلة وميدانية لا تعتمد على وعود الطرف المقابل، خصوصا في بيئات غير خاضعة للسيطرة التركية المباشرة مثل قنديل أو شرق الفرات.
وأكد أفشار أنه من دون امتلاك القوات التركية هذه القدرة ستبقى العملية معرضة لخطر الإجهاض أو إعادة التسلح لاحقا من مخازن لم يُكشف عنها.
تنسيق إقليمي
تبرز أهمية التنسيق الإقليمي في خطة تفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني بالنظر إلى تمركز النسبة الكبرى من مقاتليه وقياداته خارج الأراضي التركية، وتحديدا في المناطق الجبلية الوعرة شمالي العراق وشمال شرقي سوريا، وهو ما يجعل تسليم الأسلحة خارج الحدود أحد أبرز مفاتيح نجاح العملية.
وتشدد أنقرة على ضرورة التعاون الوثيق مع كل من بغداد وأربيل لوضع آلية ثلاثية تضمن التنفيذ الفعلي لنزع السلاح في هذه المناطق، حيث لا تخضع مواقع التنظيم عادة لسيطرة مباشرة.
ووفق ما أفاد به مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية، فقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات العراقية المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى إقليم كردستان، وسط مؤشرات على تحقيق “تقدم ملموس” في الجوانب اللوجستية والأمنية المتعلقة بتسليم الأسلحة.
في المقابل، يحذر مراقبون من احتمال ظهور فصائل منشقة ترفض الانخراط في العملية وتلجأ إلى الاحتماء في الجبال أو تعيد التمركز تحت مسميات جديدة، في حين تؤكد مصادر أمنية تركية أن الجيش سيُبقي على حالة من الجاهزية والاستطلاع النشط في المناطق الحدودية لفترة طويلة، لضمان عدم بروز أي تهديد مسلح مجددا.
ويرى المحلل السياسي التركي علي أسمر أن احتمالية بروز فصائل متشددة ترفض الانخراط في العملية تظل قائمة، وهو ما تتعامل معه الدولة التركية -بحسب وصفه- من زاويتين: الأمن القومي والشرعية القانونية.
ويشير أسمر في حديث للجزيرة نت إلى أن أي فصائل منشقة ترفض تسليم السلاح “لا تعبر فقط عن تمرد على الدولة، بل تمثل خروجا عن سلطة القيادة المركزية للحزب وزعيمه عبد الله أوجلان، مما يفقدها أي غطاء سياسي”، وهو ما يمنح أنقرة بالمقابل شرعية أمنية وقانونية كاملة للتعامل معها عسكريا، دون أن يعد ذلك تقويضا للعملية السلمية، بل امتدادا طبيعيا لها لضمان استكمالها.
أما من الناحية العملية فيلفت أسمر إلى أن تركيا لا تستبعد إطلاقا اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة ضد من يثبت تورطه في نشاطات تهدد الأمن والسلم الأهلي، مشيرا إلى امتلاك الجيش التركي خبرة طويلة في هذا النوع من العمليات النوعية الدقيقة التي تمنع تحول الفصائل الصغيرة إلى تهديد منظم.
ويختم بالقول “سواء اكتمل الحل بتفكيك الحزب كليا أو برزت جيوب معارضة فإن تركيا تملك زمام المبادرة في الحالتين، في الأولى تنهي حقبة من الصراع، وفي الثانية تكتسب تفويضا مزدوجا داخليا ودوليا لاجتثاث ما تبقى من تهديد بوسائل شرعية ومشروعة دفاعا عن أمنها القومي ووحدة أراضيها”.
وفي مؤشر على توجه الحكومة نحو إرساء أرضية سياسية موازية، كشفت صحيفة “صباح” المقربة من دوائر القرار عن نية أنقرة إطلاق “حملة دمقرطة” شاملة بعد إتمام تسليم السلاح تشمل مراجعة قوانين مثيرة للجدل، كآلية تعيين الولاة في البلديات، في محاولة لخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحا يعزز الثقة في المرحلة المقبلة.
مسار سياسي
وبالتوازي مع الخطوات الميدانية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني تتجه أنقرة نحو تفعيل مسار سياسي داخل البرلمان التركي، في إطار مرحلة جديدة توصف بأنها “انتقالية” نحو ترسيخ السلام الداخلي.
وفي هذا السياق، طرح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية موسعة تعنى بإدارة المرحلة المقبلة تحت عنوان “إستراتيجية تركيا بلا إرهاب في القرن الجديد.. لجنة الوحدة الوطنية والتضامن”.
ويقضي المقترح بأن تتولى اللجنة -التي يُنتظر أن تضم قرابة 100 عضو- مهمة وضع خارطة طريق للملف الكردي ما بعد السلاح، مع ضمان تمثيل نسبي للأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان التركي.
ووفقا لبهتشلي، فإن رئاسة اللجنة ستُسند إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، لضمان إشراف دستوري مباشر على عملها.
بدوره، أكد قورتولموش أن عملية الانتقال نحو “تركيا من دون إرهاب” تسير وفق الجدول المقرر، مشيرا إلى أن “الخطوة التالية هي تسليم السلاح، وبعد ذلك ستكون ساحة النقاش السياسي هي البرلمان، سواء من حيث التشريع أو وضع الأطر القانونية اللازمة”.
وتتماهى تصريحات قورتولموش مع موقف الحكومة التي تربط أي تحرك سياسي داخل البرلمان باستكمال المرحلة الأمنية.
وأوضح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن إطلاق النقاش البرلماني بشأن “المرحلة السياسية الجديدة” لن يتم إلا بعد صدور تقرير رسمي من جهاز الاستخبارات يؤكد انتهاء عملية نزع السلاح بالكامل.
المصدر : الجزيرة
————————
هل سنشهد عملية تركية أخيرة ضد “العمال” الكردستاني؟/ فراس فحام
السبت 2025/05/24
لا يبدو أن إعلان حزب “العمال” الكردستاني في النصف الأول من أيار/مايو الجاري، إلقاء السلاح، سيؤدي إلى وقف العمليات العسكرية التركية ضده بالكامل، نظراً لوجود حالة من الانقسام في أروقة الحزب حيال الالتزام بالإعلان الذي صدر عن مؤتمر الحزب مؤخراً.
سلاح بالعراق وتسرب إلى سوريا
وفقاً لما تؤكده المعلومات فإن مجموعات تتبع لحزب العمال الكردستاني، تسعى للاحتفاظ ببعض الأسلحة في مناطق وجودها ضمن جبل قنديل وسهل سنجار شمال العراق، على الرغم من إعلان القائد المؤسس عبد الله أوجلان في وقت سابق، التخلي عن العمل المسلح.
وتسعى هذه المجموعات لاستغلال بعض المزايا التي تتوفر لها من الانفتاح الإيراني عليها، حيث يبدو أن طهران لا ترغب بخسارة دورها وإمكانية توظيفها ضد الجانب التركي عند اللزوم، وهذا يوفر لها هوامش للبقاء.
من جهة أخرى فضلت بعض المجموعات التابعة للحزب، التوجه إلى سوريا للاستقرار ضمن مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي لديه ارتباط وثيق مع “العمال”، وهذه المجموعات من جنسيات غير سوريا ومن ضمنها تركية، لا ترغب بالعودة إلى بلادها وإنما الاستمرار بالنشاط العسكري ولكن ضمن صيغة جديدة تحت غطاء قوة تحظى برعاية أميركية حتى اللحظة.
من الواضح أن قسد تعمل أيضاً على تعزيز موقفها الميداني عبر هذه المجموعات، قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع الإدارة السورية من أجل تحديد آليات اندماج قسد ضمن الدولة السورية.
ترتيبات تركية
ينشط الجانب التركي إقليمياً من أجل ترتيب الأجواء لما قد يكون مواجهة فاصلة ضد المجموعات التابعة لـ”العمال” الكردستاني والرافضة لإلقاء السلاح، وتركز أنقرة على إجراء اتصالات مكثفة مع الجانبين العراقي والسوري لضمان الحصول على التفويض اللازم لعمليات عسكرية يلوح بها المسؤولين الأتراك الذين يؤكدون على مراقبتهم لمدى التزام “العمال” بإعلان إلقاء السلاح.
ولا يبدو أن التقارير الغربية التي أكدت تأسيس قناة اتصال بين إسرائيل وتركيا في سوريا، منفصلة عن جهود الترتيبات السياسية والأمنية التي توفر الأرضية اللازمة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد مجموعات “العمال”، حيث من المحتمل أن تكون سوريا هي الساحة الرئيسية لهذه المواجهة في ظل انتقال كوادر الحزب بشكل كثيف إلى الأراضي السورية مؤخراً.
ستساهم قناة الاتصال التركية-الإسرائيلية بتهدئة مخاوف الأخيرة من النشاط التركي في سوريا، وبالتالي ضمان عدم عرقلة أي نشاط عسكري تركي في سوريا.
من غير المستبعد أن توافق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي الأخيرة على عملية عسكرية تركية دقيقة تستهدف تفكيك ما بقي من مجموعات “العمال” الكردستاني، حيث ظهرت واشنطن مؤيدة ضمنياً لتفكيك الحزب الذي تحول تدريجياً إلى أحد أدوات النفوذ الإيراني في العراق وسوريا، خصوصاً أن مثل هذه العملية ستسهل على التيار الآخر ضمن “قسد” الاندماج ضمن ترتيبات الحل السوري، لأنه سيتخلص من الضغوطات التي تمارسها عليه كوادر الحزب.
المدن
—————————–
لا مجال للهرب من درس “آبو”/ رفيق خوري
أوجلان أعاد قراءة التجربة وليس أمام “حماس” و”حزب الله” سوى المراجعة وإلا صار الوضع الجديد عبرة لمن يعتبر
السبت 24 مايو 2025
التجربة الأخيرة في حرب غزة ولبنان درس أكبر، فلا أميركا ولا روسيا ولا الصين حاولت أو تمكنت حتى من وقف حرب الإبادة ضد غزة وشعبها، ولا الدول العربية المعترفة بإسرائيل أخذت قراراً عملياً لرفض المذبحة، وأقل ما فهمه الجميع من درس باللحم الحي هو أنه على من يريد إزالة إسرائيل العمل لإزالة أميركا.
رجل الأعمال والصناعي الأميركي أرماند هامر كان صديقاً للزعيم الشيوعي فلاديمير لينين ومن الذين ساعدوه في التصنيع وكهربة الاتحاد السوفياتي. وهو يروي في مذكراته تحت عنوان “شاهد على التاريخ” أن قائد الحزب الشيوعي “أدرك عام 1920 أن الشيوعية لن تنجح”، والمرحلة لم تكن مرحلة الشيوعية كما تصورها ماركس بل مرحلة ما سماها لينين “دولة بورجوازية بلا بورجوازيين” ثم دولة “البروليتاريا الاشتراكية” التي حين تصل إلى أعلى مراجعها تبدأ مرحلة الشيوعية مع “زوال الدولة”.
لكن خلفاء لينين، من ستالين إلى بريجنيف، بنوا دولة “الأخ الأكبر” البوليسية التي صورها جورج أورويل مع قاعدة صناعية وعسكرية قوية. وعندما جاء غورباتشوف وكشف الخلل وأراد إصلاح النظام عبر “البريسترويكا والغلاسنوست” انهار الاتحاد السوفياتي بين يديه، وهناك من يلومه على السقوط، ومن يرى أنه تأخر في رؤية ما “لن ينجح” خلال 70 عاماً.
لكن الاتحاد السوفياتي أدى أدواراً مهمة في التاريخ كان بينها دوره في دعم حركات ثورية تمارس الكفاح المسلح ضد الأنظمة المرتبطة بالإمبريالية الأميركية والأوروبية. وبين الذين تأثروا بقول لينين “إن ما يحتاج إليه المرء لإسقاط نظام ليس منظمة ثورية بل منظمة ثوريين”، كان عبدالله أوجلان “آبو”، الذي أسس عام 1978 “حزب العمال الكردستاني” في تركيا مع أيديولوجيا ماركسية-لينينية صارمة، وبدأ عام 1984 الكفاح المسلح لإقامة دولة كردية مستقلة. وعلى مدى نصف قرن من القتال وحرب العصابات في الريف و”حرب الخنادق” في المدن رأى الفشل وانتقل إلى سقف أقل علواً هو “الكونفيدرالية الديمقراطية” ثم الفيدرالية، ثم الحكم الذاتي، ثم اللامركزية والحقوق السياسية والثقافية للكرد في نظام ديمقراطي. وهذا ما قاده أخيراً إلى الاعتراف بأن مرحلة الكفاح المسلح فشلت وانتهت، وإعلان حل حزبه وإلقاء سلاحه والعمل في إطار النضال الديمقراطي، وربما كان عليه اتخاذ القرار الصعب قبل أكثر من عقدين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
والسؤال اليوم هو: ماذا عن بقية حركات الكفاح المسلح؟ هل تختلف تجربتها عن تجربة حزب العمال الكردستاني، بصرف النظر عن اختلاف الظروف؟ ماذا عن تجربة “حماس” تمثيلاً لا حصراً؟ هي ربحت الانتخابات النيابية ورئاسة الحكومة في السلطة الفلسطينية، لكنها قامت بانقلاب عسكري واستقلت بحكم قطاع غزة ضد السلطة في رام الله. وما كان ذلك من دون هدف إستراتيجي، وهو الانطلاق من رفض “اتفاق أوسلو” والإصرار على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. وهذه مهمة تحتاج، ليس فقط إلى وحدة وطنية وإرادة سياسية ومشاركة عربية ودعم دولي، بل أيضاً إلى التحرك من مكان أوسع من قطاع يعتمد على الماء والكهرباء والغذاء والدواء الآتي عبر العدو الذي يستطيع حصار غزة بالكامل، فضلاً عن الحاجة إلى قراءة عميقة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي منذ 1948 حتى اليوم، وسر الدعم الأميركي والأوروبي والسوفياتي لقيام إسرائيل ورفض إزالتها في ما بعد، مع الدعوة إلى دولة فلسطينية ضمن “حل الدولتين”.
وإذا كان الرئيس هاري ترومان قد اعترف بإسرائيل بعد دقائق من قيامها، فإن المندوب السوفياتي في الأمم المتحدة، أندريه غروميكو، قبل أن يتولى وزارة الخارجية، “اتهم الجيوش العربية التي دخلت فلسطين” لمنع قيام إسرائيل بأنها “تمارس اعتداءً على إسرائيل”. والتجربة الأخيرة في حرب غزة ولبنان درس أكبر، فلا أميركا ولا روسيا ولا الصين حاولت أو تمكنت حتى من وقف حرب الإبادة ضد غزة وشعبها، ولا الدول العربية المعترفة بإسرائيل أخذت قراراً عملياً لرفض المذبحة، وأقل ما فهمه الجميع من درس باللحم الحي هو أنه على من يريد إزالة إسرائيل العمل لإزالة أميركا.
ثم ماذا عن تجربة “حزب الله” في”حرب الإسناد” لغزة، وما لحق به من ضربات قوية وما أصاب لبنان من دمار للوصول إلى اتفاق لوقف النار وتطبيق القرار 1701 بموافقة “حزب الله” مع تصرف إسرائيل على أساس أنها منتصرة، وهي تكمل حربها من دون أي رد من “المقاومة الإسلامية”؟ ما هذه الإستراتيجية التي يتصور أبطالها أن إزالة إسرائيل ممكنة من لبنان بقرار إيراني، لا رأي ولا دور فيه للسلطة الشرعية وأكثرية اللبنانيين؟ الواقع أن الجواب على الأرض. دور الأذرع الإيرانية لحماية إيران ومشروعها الإقليمي دخل مرحلة الانحسار من قبل انهيار نظام الأسد وخسارة “الجسر السوري”، واللعبة انتهت بالنسبة إلى “المقاومة” في لبنان، لكن طهران لا تزال توحي أنها قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهي تفاوض أميركا على صفقة، و”حزب الله” لا يزال يتحدث عن الاحتفاظ بسلاحه الذي صار استخدامه مغامرة انتحارية ووصفة مؤكدة لتدمير ما بقي من لبنان.
أوجلان أعاد قراءة التجربة وأخذ العبر، و”حماس” مجبرة أقله بسبب وضع الناس في غزة على إعادة القراءة واستخلاص العبر، والوضع الجديد في لبنان لم يترك مهرباً لـ”حزب الله” من المراجعة واتخاذ العبر، وإلا صار الوضع الجديد و”حزب الله” عبرة لمن يعتبر.
وما يركز عليه كارل فون كلاوزفيتز في كتابه “نظرية الحرب” هو “أهمية الهدف السياسي” في الحرب.
———————————-
ما دلالات زيارة الشرع المفاجئة إلى تركيا؟/ زيد اسليم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. 25/5/2025
أنقرة- في زيارة غير معلنة هي الثالثة له إلى تركيا منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى إسطنبول، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولما بهتشة.
وعُقد اللقاء خلف أبواب مغلقة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين من الجانبين، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، كما ضم من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصر.
سياق الزيارة
تأتي زيارة الرئيس السوري إلى تركيا في سياق إقليمي ودولي بالغ الأهمية، إذ تزامنت مع إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الغربية بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد يومين فقط من زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق، والتي تناولت ملفات أمنية حساسة، خاصة قضية تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية، وهو الملف الذي شهد تأخرا في التنفيذ عما كان معلنا سابقا.
وتأتي أيضا في ظل تصريحات أردوغان الأخيرة حول التواصل مع العراق وسوريا بشأن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مما يعكس مساعي تركيا لتحقيق تقدم في هذا الملف الأمني الحساس.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أهم الملفات
أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن اللقاء تناول جملة من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا ومسارات التعاون بين البلدين.
وأكد الرئيس أردوغان، خلال المباحثات، أن “أياما أكثر إشراقا وسلاما” تنتظر سوريا، مجددا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري كما فعلت منذ بداية الأزمة.
ورحب أردوغان بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر ذلك خطوة مهمة تهيئ الأرضية لعودة الاستقرار.
وفي ما يخص التصعيد الإسرائيلي، وصف الرئيس التركي الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدا استمرار تركيا في رفضها هذه الانتهاكات عبر كل المنابر الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في مجالات حيوية، على رأسها الطاقة والدفاع والنقل، إذ أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوفاء بما تقتضيه علاقات “الجوار والأخوة”، بما يشمل الدعم الفني والسياسي خلال مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.
وفي المقابل، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن امتنانه للموقف التركي، مثنيا على الدور الحاسم الذي لعبته أنقرة في رفع العقوبات ودفع المجتمع الدولي للاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق.
من جهتها، قالت الوكالة السورية للأنباء إن وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيان نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري ووزير خارجيته التقيا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، لبحث تطورات الملف السوري خلال الزيارة.
في السياق، يرى الباحث في مركز سيتا للدراسات كوتلوهان قورجو أن غياب أي إعلان رسمي أو تغطية إعلامية مسبقة لزيارة الرئيس السوري إلى تركيا لا يعني بالضرورة أنها كانت سرية، بل يعكس -برأيه- ضيق الحيز الزمني للزيارة، وطبيعة الملفات الحساسة المطروحة خلالها.
ويعتقد قورجو -في حديث للجزيرة نت- أن من بين العوامل التي دفعت لعقد هذا اللقاء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتعيين السفير الأميركي لدى أنقرة مبعوثا خاصًا إلى سوريا، إلى جانب تصاعد أهمية ملف وحدات حماية الشعب (قسد) في الأجندة الأمنية التركية.
ويلفت إلى أن مشاركة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في اللقاء تعزز الاعتقاد بأن قضية انتشار القوات الكردية وقضية “المواقع العسكرية المحتملة” كانتا ضمن أولويات جدول الأعمال، إلى جانب ما وصفه بـ”التقدم الفني في الحوار التركي الإسرائيلي بشأن سوريا”، الذي قد يكون طُرح أيضًا في اللقاء.
وأضاف قورجو أن لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص توم باراك يعكس حرص القيادة السورية الجديدة على التواصل المباشر مع واشنطن، وإدراكها حساسية هذا المسار، في ظل استمرار وجود ملفات عالقة بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الزيارات الميدانية التي أجراها مسؤولون سوريون إلى تلك المخيمات قد تكون جاءت استجابة ضمنية لبعض التوقعات الأميركية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أهمية الزيارة
يرى المحلل السياسي محمود علوش أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت على المشهد السوري مؤخرا، لا سيما في ما يتعلق بمسار التسويات السياسية والأمنية.
وحسب علوش، فإن أنقرة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمعالجة ملف قسد ضمن إطار اتفاقية الاندماج الجارية، التي تشكل جزءا من مسار أوسع متعلق بإحياء عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. ويعتقد أن الظروف أصبحت ناضجة لتحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الانسجام الأميركي النسبي” مع مقاربة تركيا للملف السوري.
كما يشير إلى أن أنقرة معنية أيضا بالتوصل إلى ترتيبات أمنية ثنائية مع دمشق ودول الإقليم لمواجهة تهديد عودة تنظيم الدولة (داعش)، بما يشمل ملف تسليم سجون داعش ومعسكرات الاحتجاز إلى الحكومة السورية، وهي خطوة ترى فيها تركيا ضرورة لتمكين دمشق من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة على حدودها.
ويختم علوش بالقول إن النتائج المباشرة لهذه الزيارة ربما لا تظهر فورا، لكنها -برأيه- ستتجلى تدريجيا من خلال استكمال مسار الاندماج وتنفيذ التفاهمات الأمنية والعسكرية التي جرى التوافق عليها بين الجانبين.
المصدر : الجزيرة
——————————-
في زيارة غير معلنة.. الشرع يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث ملفات أمنية وسياسية
24 مايو، 2025
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مباحثات مهمة في إسطنبول مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة غير معلن عنها مسبقاً، تناولت تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي.
اللقاء الذي انعقد في المكتب الرئاسي داخل قصر دولمة بهشة التاريخي، شهد حضور شخصيات بارزة من الطرفين، حيث شارك من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، بالإضافة إلى رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
أما الوفد السوري فضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
ووفقاً لمصادر تركية، جدد الرئيس إردوغان خلال الاجتماع تأكيده على استمرار دعم تركيا للإدارة السورية الانتقالية بهدف تحقيق الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وشدد على أهمية التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في ما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية.
كما ناقش الجانبان مسار تنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مارس الماضي، والذي لم يشهد حتى الآن تقدماً ملموساً، الأمر الذي يثير قلق أنقرة. وتطالب تركيا بنقل السيطرة على السجون والمعسكرات التي تضم عناصر تنظيم “داعش” إلى الحكومة السورية كجزء من هذا الاتفاق.
الهجمات الإسرائيلية والعقوبات الغربية على طاولة النقاش
كما تطرقت المباحثات إلى التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما من تأثير الهجمات المتكررة على استقرار المنطقة.
كما ناقشا إمكانية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، والخطوات العملية المطلوبة لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالين، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني، بالإضافة إلى رئيس المخابرات السورية حسين السلامة.
وتناولت هذه اللقاءات التنسيق الأمني، خاصة فيما يتعلق بإعادة دمج عناصر “قسد” في صفوف الجيش السوري، وضبط الحدود والمعابر، وتسليم السجون التي تحتجز فيها عناصر تنظيم “داعش” إلى الدولة السورية.
دعوة تركية لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة
وفي هذا السياق، دعا أردوغان الحكومة السورية، يوم الخميس، إلى المضي في تنفيذ اتفاق دمج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية، في خطوة تعتبرها أنقرة ضرورية لتجفيف منابع التوتر في الشمال السوري.
ولفت إلى أن لجنة رباعية تضم كلاً من تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة تتابع ملف معتقلي “داعش” الموجودين في معسكرات شمال شرقي سوريا، والتي تسيطر عليها قوات “قسد”.
وأشار أدوغان إلى ضرورة تحمّل العراق لمسؤولياته حيال مخيم “الهول”، حيث أن معظم النساء والأطفال المحتجزين هناك من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
انطلاقة نحو تعاون دفاعي متكامل
اللقاء الرفيع شهد أيضاً مؤشرات قوية على انطلاق مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق، وسط تقارير عن اتفاق وشيك لإقامة قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.
وقد جاء حضور وزيري الدفاع من الجانبين، بالإضافة إلى رئيس الصناعات الدفاعية التركية، كإشارة واضحة إلى عمق التنسيق الدفاعي بين الطرفين.
وفي تطور لافت، كشفت وزارة الدفاع التركية عن زيارة قام بها وفد برئاسة المدير العام للدفاع والأمن، اللواء إلكاي ألتينداغ، إلى دمشق، حيث التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحثا آفاق التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.
اتفاق استراتيجي في مجال الطاقة
اقتصادياً، وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير الخميس اتفاقية تعاون مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، تشمل مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات.
وتعهدت أنقرة بموجب الاتفاقية بتزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بالإضافة إلى دعم شبكة الكهرباء السورية بما يعادل 1300 ميغاواط من الإنتاج الإضافي.
كما أعلنت تركيا استعدادها لتزويد دمشق بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية الاحتياجات العاجلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
——————————
وفد سوري رسمي بـ”الهول”.. خطوات لإفراغ المخيم من قاطنيه
السبت 2025/05/24
أكد مصدر مطلع من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، لـ”المدن”، أن وفداً رسمياً من الحكومة السورية، زار مخيم “الهول” شرقي محافظة الحسكة، برفقة مسؤولين من قوات التحالف الدولي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مناقشة أوضاع النازحين السوريين، وفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى مناطقهم الأصلية.
وبحسب المصدر، ضم الوفد ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية السورية، إلى جانب مسؤولين أمنيين من جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، في حين شارك ممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي في الاجتماع الذي عُقد داخل المخيم.
وبحث المجتمعون آليات تنظيم عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تفريغ المخيم من قاطنيه السوريين بطريقة “آمنة وطوعية”، وسط توافق مبدئي على عقد لقاءات لاحقة لمتابعة ملفات النازحين والمخيمات الأخرى في المنطقة.
وتعدّ هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تضم مخيمات كبرى مثل “الهول” و”روج” التي تؤوي آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم “داعش”، من بينهم أكثر من 16 ألف نازح سوري، إلى جانب نحو 13 ألف لاجئ عراقي، وأكثر من 6 آلاف من النساء والأطفال من جنسيات أجنبية.
اتفاق سياسي وأمني مهّد للزيارة
تأتي هذه الزيارة في أعقاب اتفاق سياسي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، في آذار/مارس الماضي، تضمّن بنوداً تقضي بدمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن هياكل الدولة السورية، إضافة إلى تسليم المعابر والحقول النفطية ومراكز الاحتجاز لدمشق، وهو ما اعتُبر تمهيداً لعودة تدريجية للنفوذ الحكومي إلى شمال وشرق سوريا.
وبالتوازي، كانت الإدارة الذاتية قد أعلنت مطلع العام الجاري السماح بعودة اللاجئين السوريين من مخيم الهول إلى مناطقهم الأصلية وفق شروط، مؤكدة أن “سقوط النظام” أزال مخاوف الأهالي، وأنها ستوفر كافة التسهيلات اللازمة.
المخيم الأخطر في العالم
ورغم انخفاض عدد قاطني مخيم “الهول” من 73 ألفاً في 2019، إلى نحو 43 ألف حالياً، ما زال المخيم يُعد من أخطر بؤر التطرف، بحسب الأمم المتحدة، التي وصفته بـ”القنبلة الموقوتة”.
وكانت “قسد” قد نفّذت حملة أمنية مطلع أيار/مايو الجاري، أسفرت عن اعتقال 20 شخصاً وضبط 15 خلية نائمة ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة داخل المخيم.
وحذرت تقارير حقوقية من تفشي الفكر المتشدد بين النساء والأطفال، في ظل بطء الاستجابة الدولية لدعوات إعادة الرعايا الأجانب وتأهيلهم، بينما تتواصل عمليات تهريب من داخل المخيم باتجاه مناطق سورية وعراقية.
مصير المخيم رهن بتفاهمات دولية
وتأتي زيارة الوفد السوري في سياق ضغط أميركي على دمشق، لتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز “داعش” ومخيمات عائلاتهم، وهو ما أكده لقاء الرئيسين الشرع وترامب في الرياض الأسبوع الماضي، حيث طالب الأخير بتولي الحكومة السورية الإشراف على 26 مركز احتجاز تضم أكثر من 12 ألف مقاتل أجنبي.
ورغم اعتراضات محلية، تستمر الحكومة العراقية في تنفيذ خطط إعادة عائلاتها من الهول، حيث استقبلت ثماني دفعات منذ بداية العام، فيما لا يزال مصير آلاف من جنسيات أخرى معلقاً، وسط غياب التنسيق الإقليمي والدولي.
————————–
كالِن في دمشق: التنسيق التركي – السعودي يعيد ترتيب الأوراق السورية/ سمير صالحة
2025.05.25
ما كان مُستبعَدًا بالأمس، بات على طاولة البحث اليوم، وعلى خطِّ العواصم الثلاث: أنقرة، الرياض، ودمشق، حيث تتضاعف جهود دعم القيادة السورية في إعادة بناء الدولة من جديد.
الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كَالِن، إلى دمشق، على رأس وفد أمني رفيع، ولقاؤه بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة، تأتي بالتزامن مع حراك سوري – تركي – سعودي – أميركي مكثف على الخط السوري:
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقرِّر رفع العقوبات عن سوريا فيلحق به العديد من العواصم الأوروبية المؤثرة.
اجتماعات مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة مع وصول وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز إلى واشنطن.
اللقاء الثلاثي الذي تم في تركيا قبل أسبوعين بين وزراء خارجية سوريا وتركيا والولايات المتحدة، والذي ركَّز على رسم خارطة طريق الحوار الأميركي السوري.
تزايد الرغبة العربية التركية الغربية في دعم السلطات السورية على مواصلة المرحلة الانتقالية.
تسريبات عن تقدُّم في الجولة الرابعة من المفاوضات التركية – الإسرائيلية الدائرة في باكو لتجنُّب الصدام بينهما في الأجواء السورية.
مؤشرات إيجابية حول تسجيل اختراق في الحوار غير المباشر بين دمشق وتل أبيب برعاية أذربيجانية ووساطات بعض العواصم العربية.
وهنا يدخل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على الخط مُعلنًا في جلسة استماع لمجلس الشيوخ: “نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بُعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمِّرة تؤدي فعليًّا إلى تقسيم البلاد”.
يواصل روبيو وهو يبرِّر لرئيسه ترمب قرار رفع العقوبات قوله إن دولًا أخرى أرادت إرسال المساعدات إلى إدارة الشرع، لكنها كانت متخوِّفة من العقوبات. فلماذا يتمسك بسياسة “ضربة على الحافر وأخرى على المسمار” ويعود ليردِّد أن كل يوم لا تقوم فيه الحكومة السورية بوظيفتها، سيكون اليوم الذي يجدِّد فيه عناصر داعش قابليتهم وقدراتهم؟ وما الذي يحاول تمريره: تقدير موقف؟ أم قراءة مبنيَّة على معلومات؟ أو تحذير وتهديد؟
ممَّا دفع كَالِن إلى العاصمة السورية هذه المرة هو:
التذكير بأن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم الذي قد تحتاجه إدارة دمشق، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم إدارة السجون والمعسكرات التي تُشرف عليها “قوات سوريا الديمقراطية” باسم التحالف الدولي وتضم آلاف عناصر داعش للسلطة المركزية في دمشق.
وبحث المسار الأمني والسياسي السوري بعد دعوات دمشق الأخيرة الفصائل والمجموعات المسلَّحة لحسم موقفها والالتزام بتسليم السلاح وحل نفسها أو الاندماج ضمن قوّات وزارة الدّفاع.
ورفض احتفاظ “قسد” بسلاحها وضرورة تنفيذ بنود اتفاقية مطلع آذار المنصرم بين الشرع ومظلوم عبدي. وتقييم نتائج اجتماع القامشلي للقيادات والأحزاب والفصائل الكردية الذي يذهب في كثير من توصياته باتجاه معاكس لتفاهمات الشرع – عبدي.
واضح تمامًا أن جهود التشاور والتنسيق بين أنقرة ودمشق تتقدَّم بشكل سريع وبأكثر من اتجاه. الترجمة العملية الأولى لذلك هي الزيارات واللقاءات المكثفة بين الطرفين وعلى أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي لتسهيل خطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
المؤشر الإيجابي الآخر هو التعاون التركي السوري في ملفات خارجية بطابع سياسي واقتصادي، مرتبطة بالمشهد السوري وتسهيل خروج دمشق من العزلة الإقليمية والدولية التي عانت منها لعقود.
الشريك الثالث لهما هو الرياض التي تحرَّكت منذ انطلاق “ردع العدوان” في أواخر تشرين الثاني المنصرم، وبعد تواصل تركي – سعودي بشكل مبكر لتوحيد الجهود والمواقف والسياسات في سوريا. لافت طبعًا أن تقرِّر واشنطن والرياض أن يكون أردوغان حاضرًا، ولو عن بُعد، خلال نقاشات الملف السوري مع الرئيس أحمد الشرع في أثناء زيارته للعاصمة السعودية ولقائه هناك بنظيره الأميركي. ثم أن يتحرَّك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان باتجاه الرياض للقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد مغادرة ترمب بساعات لإجراء تقييم شامل.
المسألة لن تتوقف إذا عند خطوة تسهيل رفْع العقوبات الأميركية عن سوريا، بل هي وصلت إلى مسارعة بعض العواصم الأوروبية لتقليد واشنطن وتفعيل قرارات مشابهة.
فيدان في دمشق من جديد لبحث مسائل سياسية وأمنية عاجلة تُناقش مع واشنطن والرياض ولا بد من تسريع اتخاذ القرارات بشأنها:
سياسة إيران وإسرائيل السورية والتهديدات المحدقة.
موضوع قسد والجمود الحاصل في تنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار بين الشرع وعبدي.
ملف داعش وضرورة فصله عن ملف الوضع القائم في شرق الفرات.
مسألة الانسحابات العسكرية الأجنبية من سوريا والتي تعني أميركا وتركيا وإسرائيل وروسيا بالدرجة الأولى.
كالِن في دمشق لتقويم نتائج مراجعة واشنطن لسياستها السورية بالشق الأمني والعسكري والتحضير لملف قسد وداعش وسط كل هذه المتغيرات والمقاربات الجديدة. لكنه هناك أيضًا تحسُّبًا لسيناريو التفجير الذي قد تبحث عنه أطراف محلية وخارجية متضرِّرة من المشهد الجديد وعلى رأسها تل أبيب وبقايا فلول داعش وجناح الصقور في “قسد”.
تُعوِّل تركيا على نتائج إيجابية ومرضية في الحوار بين دمشق و”قسد”. لكنها متمسكة بحل الهياكل العسكرية وتسليم السلاح والتراجع عن الشعارات السياسية الانفصالية المرفوعة. تريد أن يُترجَم ما يجري في الداخل التركي لناحية الملف الكردي، في شرق الفرات أيضًا خلال الحوار السوري السوري.
تؤكِّد تطورات المشهد السوري بعد إزاحة نظام الأسد أن الأمر لم يعد رقصة ظلٍّ على جدارٍ متحرِّك. الأدوار تتبدَّل بوضوح، تحت سماء مكشوفة لا تُخفي أسرارها، ولا تترك مجالًا للغموض.
وكَالِن لم يأتِ إلى دمشق لالتقاط الصور التذكارية، ولا لحجز مقعد في الصفوف الأمامية انتظارًا لرفع الستار. فأنقرة، بالتنسيق الوثيق مع الرياض، تقف اليوم إلى جانب القيادة السورية الجديدة لكثير من الأسباب السياسية والجغرافية والأمنية، المصحوبة بفهم عميق لما تعنيه محاولات إعادة ترتيب الخرائط في سوريا ومن حولها.
—————————————
الملف السوري بين أنقرة وباريس.. نقاط الالتقاء والافتراق وآليات إدارة التنافس/ محمد كساح
24 مايو 2025
يستبعد الخبراء التوصل إلى حسم للتنافس الفرنسي التركي على الأراضي السورية، خاصةً في ظل حالة الافتراق الشاسعة الناتجة عن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية، مقابل التوجه التركي نحو تصفية ملف شرقي الفرات كونه يمثل أكبر تهديد للأمن القومي، من وجهة نظر أنقرة.
ومع ذلك، فإن اتجاهات باريس وأنقرة ليست مختلفة على طول الخط، بل هناك نقاط تلاق عديدة، حيث يشترك البلدان في ملفات مهمة داخل الإقليم.
“قسد” بيضة القبان
يرى المحلل السياسي درويش خليفة أن نقطة الالتقاء في العلاقات التركية الفرنسية هي محاربة داعش، وقد اشترك كلا البلدين في التحالف الدولي، كما تم التنسيق بينهما على أعلى المستويات بالنسبة لملف اللاجئين السوريين.
وفي المقابل، فإن جوهر الخلاف بينهما يتعلق بدعم فرنسا لقوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات، ويؤكد خليفة أن هذا الخلاف كبير جدًا، لأن تركيا تصنف “قسد” على قائمة الإرهاب، وهذا الخلاف يشكل انطلاقة التنافس بين البلدين في سوريا.
وبناء على ذلك، يرى خليفة أن قطع فرنسا لعلاقاتها مع “قسد” يمكن أن يشكل البوابة الرئيسية لعلاقات حسنة مع دمشق من جهة ومع أنقرة من جهة أخرى.
ويضيف خليفة أن ترميم العلاقة بين تركيا وفرنسا يتطلب مستوى رفيعًا من التنسيق لا سيما في سوريا، كما لا يمكن تناسي التنافس القوي بين البلدين على النفوذ غربي أفريقيا، مع أهمية إدراك التركة الفرنسية الكبيرة في القارة السمراء.
الحسم مستبعد
الخلاف الواسع بين باريس وأنقرة في سوريا يعني زيادة التنافس أو الصراع الناعم، لكن هل يمكن أن تصل الأمور إلى نقطة الحسم، بحيث تُكتب الغلبة في النفوذ لأحد الطرفين؟
يقول الدبلوماسي السوري السابق، تحسين الفقير، إن الحديث عن حسم للتنافس التركي الفرنسي هو أمر مستبعد، لأن التنافس يرتكز على تباين استراتيجي عميق في الرؤى والمصالح، سواء في سوريا أو شرق المتوسط.
ويضيف، في حديث لـ”الترا سوريا”، أن ما نشهده حاليًا هو إدارة توازن هش، تتحكم فيه معادلات متغيرة تشمل الولايات المتحدة، روسيا، وإيران، فضلًا عن تفاعلات داخل الاتحاد الأوروبي والناتو. لذلك من المرجح استمرار التنافس بصيغ متعددة، مع لحظات تهدئة ظرفية أكثر منها تسوية شاملة.
ويرى الفقير أن هناك عقبات عديدة تقف أمام الرؤية الفرنسية تجاه سوريا، أبرزها محدودية أدوات التأثير الميداني مقارنة بتركيا التي تملك قوات ونفوذًا مباشرًا داخل الأراضي السورية، وشبكة من الفصائل المحلية. كما أن فرنسا ليست فاعلًا وحيدًا في شرق المتوسط، بل تصطدم رؤيتها أحيانًا بعدم توافق أوروبي داخلي أو بفتور أميركي تجاه التصعيد.
ومن جهة أخرى، يوضح الفقير أن ضعف التنسيق الفرنسي مع بعض الفاعلين العرب مثل قطر، أو التغيرات في موقف الإمارات والسعودية مؤخرًا، يجعل الرؤية الفرنسية تصطدم بواقع إقليمي معقد.
ويلاحظ الفقير الرغبة الفرنسية في تثبيت موطئ قدم رمزي في مناطق النفوذ الأميركي، لكن دون الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا أو روسيا. نظرًا لأن الوجود الفرنسي ضمن التحالف يمنح باريس ورقة سياسية أكثر منها عسكرية، لتأكيد حضورها في مفاوضات ما بعد التسوية.
أي دور لباريس في الملفات العالقة؟
في ضوء ما تورده التقارير حول تعزيز فرنسا لنفوذها العسكري بالموازاة مع الخط الدبلوماسي النشط في سوريا، يبدو لعب باريس لدور مهم في بعض القضايا العالقة مسألة محتملة، فهل يمكن أن نشهد دخول فرنسا في قنوات تفاوضية غير معلنة لتخفيف التوتر بين تركيا و”قسد”، بالتوازي مع تقريب وجهات النظر بين الإدارة الذاتية ودمشق؟
في معرض إجابته على السؤال، يرى تحسين الفقير أن فرنسا تدرك أن المواجهة المباشرة مع تركيا غير مجدية، لذلك لا يُستبعد أن تسعى عبر قنوات خلفية إلى نوع من “ترتيب المصالح” يحدّ من التصعيد، خاصة مع وجود أطراف مثل واشنطن وبرلين تسعى لمنع تفكك التحالف ضد داعش.
من جانبه يستبعد درويش خليفة أن تمارس باريس أي دور فعلي في تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية و”قسد”، انطلاقًا من أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي للمفاوضات، كما أنها تضغط باتجاه إتمام كل الاتفاقيات الحاصلة بين الطرفين، وإذن فلا مبرر لوجود طرف آخر ربما يكون معرقلًا أكثر من كونه صاحب دور إيجابي.
الترا سوريا
———————————
هكذا تمكنت بنية “العمال الكردستاني” العسكرية من الاستمرار طوال أربعة عقود/ رستم محمود
25 مايو 2025
بينما تتوالى التحليلات والمعلومات حول الآلية التي سيفكك بها حزب “العمال الكردستاني” بنيته العسكرية، التزاما بقرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر الذي عُقد مؤخرا، تتساءل الأوساط العسكرية والأمنية في المنطقة حول الأدوات اللوجستية وأشكال الانتظام العسكري ونوعية الأسلحة التي بحوزة التنظيم المسلح والتي مكنته من “الصمود” طوال أربعة عقود كاملة، في مواجهة الجيش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية، المصنفة كأحدث وأقوى جيوش المنطقة، والحاصلة على أعلى درجات التغطية والتمويل والتسليح من المنظومات العسكرية الغربية، منذ أواسط أربعينات القرن المنصرم.
أسلحة للمواجهات السريعة
تابعت “المجلة” طوال الأسابيع الماضية عددا من المقاطع المصورة التي نشرها “العمال الكردستاني” على منصاته الإعلامية حول نشاطاته العسكرية طوال السنوات الماضية، واطلعت على عدد من التقارير الأمنية الصادرة عن جهات تركية ودولية مختصة بالقضايا الأمنية، وتوصلت إلى عدة نتائج بشأن الاستراتيجية العسكرية/ التسليحية لـ”الكردستاني”.
فطوال هذه السنوات المديدة، لم ينحُ هذا التنظيم المسلح أبدا إلى أن تكون مواجهاته مع الجيش التركي مباشرة، على شكل جبهات أو سيطرة مستدامة على مناطق بذاتها. بقي الكردستاني على تلك العقيدة القتالية حتى في أوج صعوده العسكري أوائل التسعينات من القرن المنصرم. فعلى الدوام كان الخيار العسكري الأساسي بالنسبة للحزب يتمثل بواحد من خيارين: إما “الهجمات الخفيفة على المراكز الثابتة” وإما “زرع العبوات والكمائن للدوريات والقطاعات العسكرية الراجلة”، مع انسحاب سريع وآمنٍ من أية مواجهة، بغية عدم التعرض لخسائر كثيرة في الأرواح، ولإدراكه للفارق الهائل في نوعية الأسلحة والتكنولوجيا والتغطية اللوجستية في كل المواجهات.
كانت بندقية “كلاشينكوف” الروسية، تحديدا من النوعية التقليدية، الأكثر شيوعا في أوساط التنظيم، حتى أن الصورة الرمزية لقائده العسكري الأول والأكثر شهرة معصوم قورقماز تظهره وإلى جانبه تلك البندقية. فتلك البندقية كانت متوفرة بكثرة في البيئات الريفية الكردية جنوب شرق تركيا في أوائل الثمانينات حين أطلق التنظيم كفاحه المسلح، كما أن خفة وزنها وجودتها القتالية وتوفرها في السوق السوداء في دول مثل العراق وإيران في عقد الحرب الطويلة بين البلدين المجاورين لتركيا جغرافياً بسلاسل جبلية وعرة، حولت هذه البندقية إلى الخيار الأول للحزب.
لنفس الأسباب اللوجستية، فإن “العمال الكردستاني” اعتمد طويلا على قاذفات “آر بي جي/RPG-7” الروسية أيضا. فهذا السلاح استعمله الحزب على الدوام للهجوم على العربات والمقار العسكرية التركية عن قُرب، خصوصا في المناطق الريفية المعزولة. فالمدى الفعال للقاذفة (500 متر) كان يمنح مقاتليه القدرة على الاشتباك والانسحاب السريع.
بين السلاحين التقليديين، كان مقاتلو “الكردستاني” منذ أوائل التسعينات يستخدمون قناصة “دراغونوف” بغية التغطية واستهداف النقاط العسكرية عن بُعد. مصادر “العمال الكردستاني” كانت قد قالت أكثر من مرة إن المدى الفعال لهذه البندقية القناصة (1200 متر) قد تمت مضاعفته من قِبل مقاتلي الحزب ليصبح أكثر من 2000 متر، وصاروا يسمونها “بندقية زاغروس”.
على الرغم من عدم تأكيد امتلاكه للصواريخ المضادة للدبابات والعربات المصفحة من نوعي “كونكورس” و”ميتيس”، بسبب المسؤولية السياسية للدول المتسربة منها، فإن الكثير من التقارير العسكرية قالت إن تلك الصواريخ كانت السلاح الرئيس لمقاتلي الحزب أثناء المواجهات المستدامة في المناطق الجبلية الوعرة في المناطق الحدودية بين تركيا والعراق اعتبارا من عام 1993، وما يزال الحزب يمتلك المئات منها. وإلى جانبها أنظمة دفاع جوي تطلق عن الكتف، استُخدمت لإسقاط مروحيات الدعم اللوجستي التركية، لأن الأخيرة كانت مجبرة على الطيران بعلو منخفض، للوصول إلى نقاط تمركز الجيش، فكانت تدخل مدى الاستهداف من ذلك النظام. ومنها أنظمة “ستريلا”، حيث تُثبت العشرات من المقاطع المصورة المنشورة من قِبل الحزب استحواذ مقاتليه عليه منذ التسعينات.
تقارير استخباراتية تركية متطابقة تؤكد بدء “العمال الكردستاني” تدريب مقاتليه على استخدام “الطائرات المُسيرة” اعتبارا من عام 2015، متخذا استراتيجية الحصول على النوعية التجارية من تلك الطائرات، و”تحويرها” لتغدو طائرات مفخخة مُستخدمة أثناء الهجمات. كما ثبت اعتماد “العمال الكردستاني” على تلك الطائرات لنقل العتاد والدعم اللوجستي لمقاتليه المتحصنين في النقاط الحصينة، خصوصا أثناء الظروف الجوية الصعبة.
أولى الهجمات المرصودة بتلك النوعية من الطائرات حدثت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، عندما أسقط الجيش التركي طائرتين مفخختين قبل وصولهما إلى مقر عسكري للجيش التركي في محافظة هكاري التركية أقصى جنوب شرقي البلاد. وفي أواسط مايو/أيار من عام 2021 نجحت طائرات مُسيرة مفخخة في الوصول إلى قاعدة للطائرات الحربية بالقرب من مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، فيما أصابت طائرات أخرى مقر قيادة فرقة المشاة 23 في مدينة شرناخ في اليوم نفسه.
في مرحلة لاحقة، بعد عام 2020، عاد فارق القدرات العسكرية بين “العمال الكردستاني” والجيش التركي للتوسع، بعد استخدام الأخير للطائرات المُسيرة الحديثة بشكل مكثف، واعتماده على تقنيات الاستهداف المُركز للمئات من كوادر “الكردستاني”، حتى في أكثر الجغرافيات وعورة. وتمكن “الكردستاني” في مراحل لاحقة من الحصول على أنواع من “الستائر” الواقية، لا يُمكن لتلك للطائرات المُسيرة رصد مُرتديها.
انتظام عسكري متكامل
لا تُعيد الباحثة في الشؤون الأمنية بروين محمد قُدرة “العمال الكردستاني” على الثبات إلى نوعية الأسلحة التي بحوزته، بل إلى مجموعة من العوامل الأهم في مثل هذه الصراعات، حسب الباحثة، على رأسها الترتيب التنظيمي والالتزام الأيديولوجي وتشييد بنية لوجستية في البيئة الجبلية الوعرة والاعتماد على الوحدات الصغيرة للغاية أثناء الهجمات.
تضيف الباحثة بروين محمد في حديثها مع “المجلة” قائلة: “كان (العمال الكردستاني) منذ تأسيسه حريصا على خلق (تنظيم محكم) مع حقنٍ أيديولوجي وافٍ للمنتمين لصفوفه، الكوادر الأصغر سنا تحديدا، بغية الحماية من أي اختراق استخباري، قد يُطيح بقيادات الحزب. الموقع الرمزي والقيادي الاستثنائي لمؤسس الحزب عبد الله أوجلان لعب دورا في صيانة الحزب من إمكانية الانشقاق والانقسام الداخلي، حيث شهدت مختلف الأحزاب السياسية الكردية ذلك، أو ما صار يُسمى عرفا بـ(الداء الكردي). كان المجلس التنفيذي (مجلس مجتمعات كردستان) يشغل مكانة برلمان الحزب، يشرف على نشاطاته الدعائية والسياسية والمالية وحتى الاستخباراتية والعسكرية، ويضم في صفوفه الكوادر المؤسسة للحزب، إلى جانب أبرز القيادات الحديثة في التنظيم”.
تتابع الباحثة بروين محمد حديثها قائلة: “شكلت قوات الدفاع الشعبي العنصر الرئيس الذي اعتمده الحزب عسكريا، لأنها تضم قوات (حرب العصابات الهجومية) الخاصة، ووحدات المرأة الحرة، وكلاهما تنظيمان عسكريان يعتمدان على غزارة التدريب الميداني في أصعب الظروف. لكن الحزب، خصوصا بعد أواسط التسعينات، فكك كل القواعد العسكرية الكبرى، أو المجموعات القتالية المستقرة بأعداد كبيرة في أية منطقة، وصار يعتمد على الوحدات الصغيرة المتنقلة، التي يقل عددها عن 10 مقاتلين، يُسمون في أوساط الحزب (Celik)، متنقلة في المناطق الجبلية الوعرة، سواء داخل تركيا أو خارجها. بموازاتها كان ثمة (الوحدات الحضرية)، المستقرة داخل المدن والبلدات، أو بالقرب منها، ومهمتها تغطية نشاطات الحزب الاستخبارية في المدن، وتقديم الدعم اللوجستي للمقاتلين المتنقلين، خصوصا في المجالات التسليحية والمالية والصحية، وتنفيذ عمليات عسكرية لو تطلب الأمر، كما حدث أكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية”.
بقاء رغم التحولات
أسس “العمال الكردستاني” عددا من القواعد العسكرية في السلاسل الجبلية الوعرة، تحديدا في المثلث الحدودي التركي-العراقي-التركي، في جبال هكاري وميتنى وكارى وخواكورك وآفشين وقنديل.
كانت تلك القواعد العسكرية مقار ثابتة لتنظيمات “العمال الكردستاني” طوال أربعة عقود، ولم يتمكن الجيش التركي من قصفها أو الوصول إليها، بسبب موقعها الجغرافي المعقد، والذي كان يتطلب هجوما بالأفراد المشاة، وهو ما لم يغامر به الجيش التركي أبدا. فحسب المطلعين، ثمة كهوف جبلية في تلك المناطق يصل عمقها لأكثر من 500 متر، والوصول إليها يتطلب السير بممرات ضيقة للغاية، مُسيطر عليها من قِبل قناصة الحزب.
يصنف المراقبون العسكريون والأمنيون صراع “العمال الكردستاني” مع الجيش التركي في ثلاث مراحل، تختلف كل واحدة منها عن الأخرى حسب نوعية المواجهة والتمركز التي كان يعتمدها الحزب كل مرة.
فمنذ أواسط الثمانينات وحتى عام 1993، خاض مقاتلو الحزب حرب عصابات ريفية واسعة، مستلهمين تجارب عالمية مثلما حدث في كوبا، متوقعين انتفاضات شعبية مؤيدة لهم، وسيطرة على البيئات المدنية الجبلية. وهو أمر حدث نسبيا، وتوج بمبادرة السلام التي عرضها الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال في عام 1993.
انتهت تلك المرحلة بفشل مبادرة السلام، عقب وفاة الرئيس أوزال، حيث وُجهت أصابع الاتهام بالاغتيال إلى مؤسسات “الدولة العميقة”، بغية إفشال المشروع، بعد حصول تركيا على أسلحة فتاكة حديثة، وبدء تأسيسها للوحدات القروية “الكردية” المساندة للجيش التركي أو ما يعرف باسم “قروجي”، مع تحطيم منهجي لكل القرى والزعماء المحليين غير المتعاونين مع الجيش.
المرحلة الثانية كانت خلال سنوات (1993-1999)، أي منذ فشل مبادرة السلام وصولا لاعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان. خلال هذه المرحلة، استفاد الحزب من إخلاء مقاتلي الأحزاب الكردية-العراقية لمقارها الحدودية الحصينة، عقب نجاح انتفاضة عام 1991 ضد النظام العراقي السابق، وصار يتخذ منها مراكز دعم لوجستية لشن هجمات عبر الحدود، تمكنت من تكبيد الجيش التركي خسائر كبرى، مقارنة بالسنوات السابقة.
تمكنت تركيا من ضبط ذلك التحول عبر ثلاث آليات: الهجمات البرية إلى داخل أراضي إقليم كردستان العراق، والضغط العسكري على سوريا لتسليم زعيم الحزب عبد الله أوجلان، واستعمال نفوذها الدولي للضغط على إيران وروسيا والنظام العراقي السابق، الدول التي كانت تركيا تتهمها بدعم “العمال الكردستاني” عسكريا.
المرحلة الأخيرة كانت عقب اعتقال أوجلان ومحاكمته، حيث طالب مقاتليه بالانسحاب من الأراضي التركية، وترك مجال واسع للحلول السياسية.
طوال هذه المرحلة، الممتدة من عام 2000 وحتى الآن، خصوصا بعد عام 2002 مع وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى سُدة الحكم في تركيا وتقديم نفسه كتيار سياسي مختلف عن الطبقة السياسية التقليدية، التابعة/الملتزمة بشروط وفروض النُخبة العسكرية ومحافل الدولة العميقة، صار “الكردستاني” يستخدم هجمات عسكرية محدودة للغاية، لا تزيد عن خمس هجمات في العام، بغية التذكير بوجود قضية كردية في البلاد، ودفع القوى السياسية والدولة العميقة للتفكير بإيجاد حلول سياسية عبر مفاوضة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان.
لقد أُطلق كثير من المبادرات، سواء في عام 2008 أو في عام 2013، إلا أنها باءت بالفشل، بسبب الخلافات داخل البيئة السياسية الداخلية التركية، أو بروز عوامل خارجية معرقلة، وهو ما تقول السلطة التركية إنها ستتجاوزها بكل شكل هذه المرة.
المدلة
————————–
==========================
لقاء الشرع-ترامب ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تحديث 25 أيار 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
———————————-
الإدارة السورية بين الخارج والداخل/ بشير البكر
24 مايو 2025
تمكّنت الإدارة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من القيام بخطوات مهمّة على مستوى تقديم نفسها خارجياً. وقد حظيت في زمن قياسي باعتراف وقبول عربيَين ودوليَين، ونالت ثقةً أهّلتها لتبني علاقات عربية وإقليمية وازنة مع كلّ من السعودية وقطر وتركيا، الأمر الذي فتح أمامها أبواب عدّة عواصم، ومكّنها من لقاءات ذات طبيعة استراتيجية، وخاصّة اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، في 14 مايو/ أيار الحالي، بعد زيارته فرنسا، بوابة الاتحاد الأوروبي، في السابع من الشهر نفسه. وأهم نتيجة لذلك قرار رفع العقوبات الأميركية، ومن ثمّ الأوروبية، عن سورية.
ما كان للاستقبال الدولي للشرع، والرفع السريع للعقوبات الأميركية والأوروبية، أن يحصلا بهذه السرعة لولا حملة العلاقات العامّة، والاتصالات التي قامت بها السعودية وقطر وتركيا. وهذا يعني أن الدول الثلاث، ذات الوزن السياسي والاقتصادي، والدور المؤثّر إقليمياً ودولياً، حريصة على وضع سورية في سكّة الاستقرار من باب رفع العقوبات، وهي تدرك أن لا سبيل إلى معالجة التركة الثقيلة، التي تركها نظام بشّار الأسد، إلا بحلّ المشكلات الاقتصادية، لأن سورية أكثر ما تعاني من ذلك، وبناها التحتية شبه مدمّرة، وتحتاج مساعدات خارجية كبيرة كي تبدأ أولى خطوات التعافي، وتمهيد الطريق لعودة قرابة خمسة ملايين مهجّر يعيشون في تركيا والأردن ولبنان، ويشكّلون ضغطاً كبيراً منذ عدة سنوات على اقتصادات (وخدمات) هذه الدول، التي لم تقصّر عن مدّ العون لهم في الظروف الصعبة، وآن أوان عودتهم إلى بلدهم.
هناك حرص عربي ودولي على استقرار سورية، ولا تأتي من فراغ تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ الأميركي، لذا يجب أخذ تحذيراته على محمل الجدّ، وخاصّة في ما يتعلّق بالعواقب الناجمة عن تأخير رفع العقوبات. وهذا يتطلّب من الإدارة السورية التقاط الرسالة الدولية وترجمتها بسرعة، من خلال العمل في استثمار النجاحات على المستوى الخارجي، وتحويلها أرضيةً داخليةً متينةً لاستقبال الدعم الدولي، ولا يمكن أن يتم ذلك من دون وضع استراتيجية سياسية واقتصادية ودبلوماسية، تعمل في هذه الجبهة، لأن قرار رفع العقوبات لا يعني أن المسألة باتت ناجزةً فترسل الدول العربية والأجنبية المليارات لسورية بين عشية وضحاها من أجل إعادة إعمارها. ليس هناك مال بلا مقابل، وما من استثمارات من دون ثقة واستقرار، وما لم تنجح الإدارة السورية في تعزيز وضعها الداخلي، من خلال التشاركية في الحكم، فإن الرصيد الخارجي الذي حقّقته لا يكفي لوحده من أجل دفع العربة إلى الأمام.
أول خطوة مطلوبة أن تكون الأرضية الداخلية صلبة، وتعتمد الدولة السورية الجديدة على الكفاءات لا الولاءات، وهذا يتطلّب مراجعةً سريعةً من الرئيس الشرع الذي يشرف على عمل الحكومة وأدائها، ويستخلص الدروس بعد تشكيلها، ويبادر إلى سدّ الفجوات، وتصحيح العثرات في مجالات منظورة، باتت حديث الرأي العام، وتحوّلت معياراً للحكم على مستقبل ومسار الحكومة الانتقالية، وأهم نقطة يجري الحديث عنها هي عدم المهنية في مجالات عدّة، إذ أسندت المسؤوليات إلى أشخاص لا يتحلّون بالكفاءة الضرورية.
وتتمثل الخطوة الثانية في ضرورة العمل على نحو جادّ لتعزيز السلم الأهلي، من خلال البدء سريعاً بإطلاق مسار العدالة الانتقالية، بعد تشكيل الهيئة الخاصّة بها، ومعالجة نتائج الأحداث التي شهدها الساحل في مارس/ آذار الماضي، ومن بعدها جرمانا وصحنايا والسويداء، التي تشكّل جراحاً مفتوحةً تحتاج إلى التعامل معها بروح من الوحدة الوطنية الفعلية، التي تترجم شعار “الشعب السوري واحد”، وليس على أساس جرعاتٍ أمنيةٍ مؤقّتة، يمكن أن تعطي مفعولاً عكسياً على المدى البعيد.
العربي الجديد
—————————————
رفع العقوبات لم يكن مكافأة بل شرطاً للنجاة/ مها غزال
الأحد 2025/05/25
من السهل أن نُحمل السياسة مسؤولية الدمار، لكن الأصعب أن ندرك أن الاقتصاد حين يُخنق، يُحول المجتمعات إلى عبوات ناسفة. في سوريا، لم تكن العقوبات الاقتصادية مجرد أداة ضغط على النظام، بل تحولت إلى حصار وجودي ضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي، وأجهز على شرطٍ جوهري للاستقرار: الطبقة الوسطى.
المجتمع السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب، لم يعد ساحة حوار بين رؤى سياسية، بل ساحة صراع بين ثلاث طبقات لا تتواصل. طبقة عليا، وهي غالباً من أثرياء الحرب، تعيش فوق المجتمع وتتعامل مع الدولة بوصفها شركة خاصة، تراكم الثروة من أنقاض المؤسسات، ولا ترى في الاستقرار سوى تهديد لاحتكارها. وطبقة فقيرة، منهَكة، لا تملك ترف التفكير أو التنظيم، تُنفق طاقتها في تأمين الخبز، فتكون أكثر عرضة للتهميش أو حتى للتطرف كرد فعل على العوز والخذلان. أما الطبقة الوسطى، التي كانت يوماً ما صمّام الأمان، فقد تآكلت بفعل انهيار الاقتصاد وتدهور التعليم والتهجير، ومعها اختفى الفضاء الذي يسمح بالتعدد، بالاعتدال، وبفكرة الوطن المشترك.
العقوبات، حين عطّلت السوق، لم تسقط النظام فقط، بل أسقطت البنية الاجتماعية التي تسمح بتوازن المصالح وتداول السلطة، وهجّرت الكفاءات، وخنقت المشاريع، وأبقت الناس أسرى لاقتصاد مافيوي مغلق.
ومن هنا، فإن رفع العقوبات لا ينبغي أن يُفهم كمكافأة سياسية، بل كضرورة أخلاقية واستراتيجية لإعادة بناء التوازن المجتمعي. فالاقتصاد، حين يتحرك، لا يُنتج فقط فرص العمل، بل يُعيد الثقة، ويمنح الناس ما يخافون عليه، فيؤمنون بالتعايش بدل الانفجار. الاقتصاد هو السياسة بلغة أخرى، كما يقول علماء الاجتماع السياسي، وهو الذي يخلق المصالح المشتركة، ويفرض المساومة، ويحوّل التعدد إلى تفاهم لا إلى تنازع.
التاريخ القريب يقدم لنا مثالاً مأساوياً في العراق. بين عامي 1990 و2003، أدى الحصار الاقتصادي إلى تفكك الطبقة الوسطى العراقية بالكامل. تفككت المدارس والمشافي، غادرت العقول الجامعات، وانسحب المجتمع من الفضاء العام. وحين جاء الغزو الأميركي، لم يجد مجتمعاً متماسكاً، بل بيئة مثالية لانفجار طائفي دمّر الدولة وأطلق يد الميليشيات. كان الحصار قد مهّد لذلك كله باسم “الضغط الدولي”، لكنه في الواقع أنهى ما تبقى من قدرة المجتمع على النجاة من العنف. على الطرف الآخر من هذا الطيف، تقف خطة مارشال كنموذج مضاد، تبنته الولايات المتحدة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. بدل العقوبات، اختارت الاستثمار في إعادة البناء، ليس فقط في البنية التحتية، بل في التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة، ما أدى إلى استعادة الطبقة الوسطى وولادة ديمقراطيات مستقرة.
تحتاج سوريا اليوم، إلى خطة مارشال على مقاسها، لا بالضرورة من الغرب، بل من الداخل ومن شركاء الإقليم، تقوم على إعادة تحريك الإنتاج، وتمكين المشاريع الصغيرة، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وفصل الاقتصاد عن الولاءات العسكرية والسياسية.
إعادة الطبقة الوسطى ليست ترفاً برجوازياً، بل ضرورة فلسفية وأخلاقية لأي عقد اجتماعي. فهذه الطبقة هي نقيض التطرف، لأنها لا تملك رغبة السيطرة المطلقة كالطبقة العليا، ولا تعاني من العدم الوجودي كالطبقة الفقيرة، بل توازن المصالح والخوف والواقعية. هي التي ترى في التعايش خياراً، وفي الوطن مشروعاً، وفي الغد إمكانية. العقوبات تطيل عمر النظام القديم، لكنها تمنع ولادة الجديد. ومن دون الطبقة الوسطى، تبقى سوريا جسداً بلا عمود فقري، ودولة بلا مجتمع.
المدن
———————————-
الخزانة الأميركية تخفف العقوبات عن سورية.. وروبيو يعلّق إجراءات “قانون قيصر”/ محمد البديوي
24 مايو 2025
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سورية بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها. وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان “فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية أميركا أولا”. وأوضح البيان أن “وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سورية”، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهور الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سورية بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
وأضاف البيان: “كما وعد الرئيس، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سورية”، وشدد على أنه يجب على سورية مواصلة العمل لتتحول إلى “دولة مستقرة تنعم بالسلام”، معربا عن أمله أن تمهد إجراءات اليوم الطريق لها نحو مستقبل أفضل ومستقر. وأكد البيان أن رفع هذه العقوبات يمثل “فرصة لبداية جديدة، وبدء فصل جديد في حياة الشعب السوري”، وأن “حكومة الولايات المتحدة تلتزم بدعم استقرار سورية ووحدتها لتعيش في سلام مع جيرانها”، مضيفا أنه “تم تمديد تخفيف العقوبات ليشمل الحكومة السورية الجديدة بشرط ألا توفر البلاد ملاذا للمنظمات الإرهابية وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية”.
ويجيز القرار المعاملات المحظورة بموجب العقوبات الاقتصادية على سورية، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات المالية وغيرها، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. ويجيز أيضا جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة ومع بعض الأشخاص المحظورين. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنه “تماشيا مع اللائحة العامة، تقدم شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة لمصرف سورية المركزي”، مضيفة أن هذه القرارات والتفويض “تهدف إلى المساعدة في بناء اقتصاد سورية وقطاعها المالي وبنيتها التحتية بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الِأميركي ماركو روبيو، عن رفع عقوبات قانون قيصر على سورية لمدة 180 يوما (6 أشهر)، مستخدما سلطاته طبقا لنص القانون الذي يتيح له التنازل عن العقوبات لمدة معينة، دون الحصول على موافقة من الكونغرس الأميركي. أوضح الوزير في بيان له أن تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات على سورية من خلال رفع عقوبات قانون قيصر الإلزامية يضمن “عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات تساهم في الاستقرار وإعادة الإعمار، وأنها تسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتساهم في زيادة فاعلية الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء سورية”.
وأكد الوزير أنه قراره إضافة للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة بالسماح بمعاملات الأشخاص الذين كانوا محظورين سابقا، يعنيان “رفع العقوبات فعليا عن سورية”، مضيفا أن “الرئيس ترامب يتيح للحكومة السورية فرصة لتعزيز الاستقرار والسلام داخل سورية وفي علاقاتها مع جيرانها”.
وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد “التطورات الميدانية في سورية، ولفتت إلى أن القرار يعد “خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 مايو/ أيار بشأن رفع العقوبات عن سورية. وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني “نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات”، كما لا يسمح بالمعاملات تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية، مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن “الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية”، وأن “الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح”. ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سورية والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سورية في المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والمعاناة.
وأمس الخميس، أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم الفني لسورية بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق “يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سورية على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك”. وتضرر اقتصاد سورية بشدة جراء حرب أهلية دامت 14 عاماً وانتهت في ديسمبر/ كانون الأول بإسقاط نظام بشار الأسد. وقالت كوزاك “ستحتاج سورية إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية… نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”. وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سورية في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار. يذكر أن صندوق النقد أجرى آخر تقييم لسياسات سورية الاقتصادية في 2009.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: “نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة تتسم بالشمول ويعمها السلم”. وذكرت كالاس “دائماً ما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين طوال الأربعة عشر عاماً الماضية، وسيواصل فعل ذلك”. وجاء في بيان إعلان القرار أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على العقوبات المتعلقة بنظام بشار الأسد “بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما يشمل الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تستخدم للقمع في الداخل”. وأضاف البيان أن التكتل “سيطبق أيضاً تدابير تقييدية إضافية بحق منتهكي حقوق الإنسان ومن يذكون عدم الاستقرار في سورية”.وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على موقع إكس “سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سورية”.
ونشرت وزارة الخارجية السورية بياناً قالت فيه إن رفع العقوبات يفتح آفاقاً جديدة للتعاون. وأضافت “تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة”. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان مكتوب “يريد الاتحاد الأوروبي أن يبدأ بداية جديدة مع سورية… لكننا نتوقع أيضاً سياسة شاملة داخلها تشمل جميع الأطياف السكانية والدينية”. وأضاف “من المهم لنا أن تتمكن سورية الموحدة من تقرير مستقبلها”.
وفي تعليق رسمي من دمشق، رحّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بالقرار الأميركي القاضي بإعفاء سورية من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”. وأكدت الوزارة أن سورية تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بالحوار والدبلوماسية لبناء علاقات متوازنة. وأشار البيان إلى أن سورية تُقدّر كل الشعوب والدول التي تقف إلى جانبها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره الإرهاب، واستعادة مكانة سورية الطبيعية في الإقليم والعالم.
العربي الجديد
———————————-
أبرزهم الشرع.. 28 شخصية ومؤسسة سورية رفعت عنهم واشنطن الحظر/ محمد البديوي
24 مايو 2025
الخزانة الأميركية أعلنت تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سورية
روبيو يعلّق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 6 أشهر
ترامب التقى الشرع في الرياض وتعهد برفع العقوبات عن دمشق
ينشر “العربي الجديد” قائمة الأشخاص والمؤسسات السورية التي رفعت عنها الولايات المتحدة الحظر اليوم، طبقا للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة. شملت القائمة 28 شخصا ومؤسسة على رأسها أحمد الشرع ومصرف سورية المركزي والخطوط الجوية السورية ومؤسسة النفط والإذاعة والتليفزيون والموانئ والملاحة السورية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
وفيما يلى القائمة كاملة:
1- الخطوط الجوية العربية السورية
2- سيترول
3- أحمد الشرع
4- أنس حسن خطاب
5- المصرف التجاري السوري
6- مصرف سورية المركزي
7- المؤسسة العامة للنفط
8- الشركة السورية لنقل النفط
9- الشركة السورية للنفط
10- المصرف العقاري
11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
12- شركة مصفاة بانياس
13- شركة مصفاة حمص
14 – المصرف الزراعي التعاوني
15- المصرف الصناعي
16- بنك التسليف
17- بنك التوفير
18- المديرية العامة للموانئ السورية
19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
20- غرفة الملاحة السورية
21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري
22- الشركة السورية للوكالات الملاحية
23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس
24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
25 – وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
26- وزارة السياحة السورية
27- فندق فور سيزونز دمشق
28- الشركة السورية للغاز
وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سورية بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها. وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان “فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا”. وأوضح البيان أن “وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سورية”، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سورية بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد “التطوارات الميدانية في سورية”، وأشارت إلى أن القرار يعد “خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 مايو/ أيار بشأن رفع العقوبات عن سورية. وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني “نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات”، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن “الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية”، وأن “الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح”. ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سورية والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سورية في المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والمعاناة.
———————————-
رفع العقوبات و”الممانعة” الجديدة في سورية/ راتب شعبو
24 مايو 2025
يشكّل قرار رفع العقوبات عن سورية بدايةً جيّدةً للسوريين، لا يغيّر من جودتها أن مسار رفع العقوبات طويل ومعقّد، كما هي أروقة المؤسّسات الأميركية التي تتحكّم بالعالم. فلا خيار لبلد منهك كبلدنا سورية (اليوم) سوى خدمة مصالحه عبر الاندماج بالعالم، وليس عبر الانكفاء أو “الممانعة”. كما لا يغيّر من جودة هذه البداية أننا سندفع ثمناً لقاء ذلك، فلا أحد يمنّ على أحدٍ في السياسة، ولا يوجد تسوّل أو مكاسب مجّانية في السياسة. ما ينبغي الحرص عليه ألا يكون الثمن عميقاً أو استراتيجياً إلى حدّ يطاول حقوقاً وطنية، ليس التخلّي عنها أصلاً من صلاحيات السلطات، حتى لو كانت مُنتخَبةً، وهذا ممّا يدركه صنّاع القرار في العالم، ويأخذونه في الحسبان.
فيما يخصّ العقوبات الاقتصادية العامّة، كان موقف صاحب هذه السطور مضادّاً على نحو دائم لفرضها على بلدان تحكمها سلطات أمر واقع، تفرض ذاتها على شعوبها بقوة السيطرة على أجهزة الدولة، كما هو الحال في بلداننا المنكوبة. كانت قناعته دائماً أن العقوبات تعاقب الشعوب مرّات، قبل أن تعاقب الأنظمة مرّة واحدة. وأكثر من ذلك، كثيراً ما استخدمت الأنظمة “التقدّمية” العقوبات الأميركية دليلاً على مواقفها الوطنية، مستغلّة الشعور الشعبي العام المعادي للولايات المتحدة بسبب موقفها الداعم لإسرائيل بصفة خاصّة. وكثيراً ما برّرت هذه الأنظمة كلّ أشكال سوء الاقتصاد وفساد الإدارة فيها بردّها إلى العقوبات، واستجرّت من ذلك حجّةً إضافيةً لقمع أيّ صوت مخالف، أي توسّلت العقوبات نفسها في خدمة إدامة سيطرتها.
لم نشهد أن نظاماً سياسياً سقط بفعل العقوبات الاقتصادية. ما شهدناه أن شعوباً جاعت، وبلداناً تهشّمت بسببها. شهدنا هذا مثلاً في العراق وليبيا وسورية، وفي هذه البلدان كلّها لم يسقط النظام (بعد كلّ شيء) إلا بفعل تدخّل عسكري خارجي مباشر أو شبه مباشر، بعد سنوات طويلة من عقوبات جعلت حياة عامّة الناس ومعنوياتهم في الحضيض، كما خلقت سوقاً إضافية للفساد.
فرحة السوريين الكبيرة بقرار رفع العقوبات لا تنبع فقط من سوء الحال الاقتصادي الذي انتهوا إليه في ظلّ نظام الأسد، وأملهم في تحسّن حالهم المعيشي، أي لا تنبع من الجانب الاقتصادي فقط، فربّما كان الجانب السياسي في فرحة السوريين أكثر أهميةً، ذلك أن القرار الأميركي، الذي تلاه قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، مؤشّر إلى القبول العالمي بالسلطة الجديدة التي لا يزال قطاع واسع من السوريين (السُّنة بوجه خاص) يخشى أن تفشل أو تتعثّر بشكل يمهد لعودة نظام ما قبل “ردع العدوان”. هذه الخشية، رغم ضعف أساسها الواقعي، تكمن في صلب الحساسية الشديدة التي يظهرها المتخوّفون، تجاه أي نقد يوجّه إلى السلطة الجديدة في دمشق. ويمكن الإشارة مروراً هنا إلى أن الطبيعة “الجهادية” للقوى التي سيطرت عقب انهيار نظام الأسد، وشكل إدراكها للعالم، ونظرتها للمجتمع، يجعل النقد الدائم والصريح والاحتجاج الفاعل والمثابر ضدّها من الأفراد، والقوى ذات الوعي الوطني، هو على عكس ما يتصوّر المتخوّفون، التعبير الأمثل عن الحرص على عدم تعثّر المرحلة الانتقالية، وتحوّلها مستنقعاً دائماً من الصراعات العقيمة.
الاحتفال الواسع برفع العقوبات يعرض قبولاً شعبياً بالاندماج في العالم كما هو، وقبولاً للعمل وفق الحدود والمعايير التي يرسمها سادة العالم الذين غالباً ما كانوا يعتبرون أعداء الأمّة. يمكن وصف هذا التيّار بأنه ميل إلى خلع “الممانعة”. في المقابل، تمارس نسبة مؤثّرة من الفصائل الحاكمة اليوم نزوعاً معادياً للعالم، ومضادّاً لقيمه ومبادئه الحديثة، لصالح إحياء ماضٍ لا يمكن إحياؤه إلا كما تُشاد المقامات على القبور. التناقض بين النزوع الشعبي الاندماجي مع العالم، والنزوع الانعزالي المغلق والمعادي للعالم من تيّار مهم داخل السلطة الحاكمة، سيكون من سمات المرحلة السورية المقبلة.
حكمت السوريين عقوداً طويلة ممانعة تمسخ المقاومة إلى وسيلة لاحتكار السلطات والسيطرة على المجتمع، ولا نعتقد أن السوريين يريدون أن تحكمنا اليوم “ممانعة” جديدة تمسخ الدين إلى وسيلة لتسويغ العنف ضدّ المجتمع وإحكام السيطرة عليه. في الحالتَين، يجري حقن الوعي العام ضدّ عدو خارجي ضعيف التحديد على أنه شديد العداء للأمة (التي يختلف تعريفها هنا وهناك)، عدو يمكن أن يخترق المجتمع عبر عملاء داخليين، هم ببساطة كلّ من يعارض أو يعترض على “الممانعين”، ولذلك يذهب المخالفون للسلطة ضحيةَ عنف لا يرحم، ذلك أن العنف هو كلّ ما يتبقّى بعد الإفلاس السياسي. أمّا العدو الخارق الذي يلعنه الممانعون، ويقدّسونه في الوقت نفسه، فإنه لا يبقى في مأمن من أذى “الممانعة” فقط، بل إن جلّ ما تطمح إليه هذه، هو أن تنسج معه علاقة تعايش فيها عداء ظاهر وإذعان فعلي. الطريف أن تاريخ الممانعين السابقين واللاحقين في سورية، هو تاريخ تبادل الاتهام بالعمالة وتاريخ من السحق المتبادل.
جاءت مفردة “الممانعة” لتكون مسخاً لغوياً للمقاومة، واستخدمت للتغطية على نزوع سلطوي يسعى إلى حيازة شرعية أبدية عبر الكلام عن مواجهة عالم شرير مقتدر من موقع طاهر “أبدي”، هو التمسّك بالحقوق القومية. ويصلح الأمر نفسه، وفق المنطق نفسه، من أجل التمسّك بالقيم الدينية. والحقّ أن التمسّك بالسلطة هو الغاية التي تسبق أيَّ حقوق وأيَّ قيم، ولا يضير السلطة “المُمانِعة” فشلها في ادّعائها حماية الحقوق، ذلك أن العدوّ متفوّق وشديد العداء.
يتماشى مع حديث الممانعة الكلام عن “الخصوصية المحلّية”، التي يجري مدحها ورفعها فوق الشروط الواقعية، كي تكون وسيلةً صالحةً ضدّ الأخذ بالقيم العالمية الحديثة التي تفرض المشاركة السياسية وتحترم حقوق الإنسان، أي كي تكون صالحةً لسند حكم “أبدي” لا يعترف بغير ذاته. وغالباً ما ينتهي الأمر، في مثل هذه الحالات، إلى دمار واسع، وإلى صغار أمام قوى العالم الحديثة، التجربة التي شهدتها شعوب منطقتنا مراراً وتكراراً.
العربي الجديد
——————————–
سوريا بين سباقين: مشاريع النهوض الاقتصادي والانفجار الاجتماعي/ إياد الجعفري
الأحد 2025/05/25
قبل عقد ونصف، كانت سوريا في المركز من معظم خرائط ومشاريع الممرات التجارية وخطوط نقل الطاقة المتنافسة. قبل أن يخرجها نظام بشار الأسد من كل تلك الآفاق، حينما ارتضى تحويلها ساحة للتصويب على ما لا يُرضي حليفيه الإيراني والروسي من مشاريع إقليمية لوجستية واقتصادية. اليوم، تستعيد سوريا مكانتها سريعاً، وبصورة دراماتيكية أيضاً.
خلال الشهر الجاري، تم الحديث عن كثير من اللقاءات والنقاشات مع مستثمرين وشركات تستقصي فرص العمل في “سوريا الواعدة”. لكن أربعة مشاريع ملفتة وضخمة وجدت طريقها، سريعاً، لتتحول إلى اتفاقات موقّعة، بالتزامن مع تغيّر نوعي تاريخي بالعُرف السوري الممتد لأكثر من 46 عاماً. إذ باتت سوريا غير معاقبة دولياً، أو على الأقل، في طريقها لذلك، بصورة شبه كاملة.
أولى تلك الاتفاقات التي جرى توقيعها مطلع الشهر الجاري، مع شركة CMA CGM -أيقونة الشحن الفرنسية- التي حصدت محطة الحاويات بميناء اللاذقية لـ30 عاماً، باستثمارات تقدّر بنحو 260 مليون دولار. وبضجيج إعلامي وترويجي أقل، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة الفرنسية ذاتها، قبل يومين، تنص على إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق. بالتزامن، وقّعت هيئة المنافذ أيضاً، مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية. وشملت مذكرة التفاهم أيضاً منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي، حسب بيان هيئة المنافذ. اللافت، أن استثمار الشركة الصينية في المنطقة الحرة بعدرا، يتلاقى -أو لنقل يتكامل- مع استثمار شركة CMA CGM الفرنسية. وكما نذكر، في منتصف الشهر الجاري، وقّعت هيئة المنافذ السورية، مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار، مع شركة موانئ دبي العالمية، لتطوير ميناء طرطوس، إلى جانب التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية في البلاد.
هناك بطبيعة الحال، جملة نقاط مثيرة للاستفهام حول هذه الاتفاقات. أبرزها، غياب التفاصيل في الاتفاقات الثلاثة المعلنة أخيراً. ففي الاتفاق مع شركة “موانئ دبي”، لم يتم الكشف عن المدة الزمنية لاستثمار ميناء طرطوس، أو مواقع الموانئ الجافة ومحطات عبور البضائع المزمع تنفيذها. أما في حالة العقد مع الشركة الصينية Fidi Contracting، وبغض النظر عن الشكوك التي أثارها نشطاء حول هوية الشركة المجهولة للكثير من رجال الأعمال السوريين ذوي الخبرة في السوق الصينية، تبقى المشكلة الأبرز، في غياب التفاصيل عن قيمة العقد، وطبيعة المشاريع المزمعة. مع الإشارة إلى أنه تم الكشف عن مدة العقد -20 عاماً- فيما تغيب أية تفاصيل تماماً، عن طبيعة العقد الأخير الموقّع مع CMA CGM الفرنسية، بخصوص إنشاء موانئ جافة. فلا تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته المالية.
وإن تركنا مصادر القلق الناجمة عن غياب التفاصيل، جانباً بصورة مؤقتة، يمكن النظر بإيجابية عالية إلى طبيعة المشاريع الموقّعة ودلالاتها. فهي شملت الميناءين البحريين الرئيسيين في سوريا. مع الإشارة في مشروعين، إلى إنشاء موانئ جافة في مواقع استراتيجية بسوريا. والموانئ الجافة، كما هو معروف، مراكز مخصصة لاستقبال البضائع وتخزينها وشحنها، تكون داخل اليابسة، بدلاً من تنفيذ هذه الخدمات في الموانئ البحرية. والجدوى من هذا النوع من الموانئ، هو توفير خيارات إضافية تزيد من سلاسة سلاسل التوريد والشحن، وإتاحة مساحات أكبر لتخزين البضائع وصيانة مركبات الشحن والحاويات، وتنفيذ خدمات الفحص والتخليص الجمركي. إن وضعنا ما سبق في الصورة إلى جانب الدخول الصيني في مجال الاستثمار الصناعي الإنتاجي بسوريا، عبر استثمار منطقة حرة بأكلمها، تفيد الصورة الإجمالية حينها، بأن سوريا اليوم، في نظر المستثمرين أصحاب المشاريع الأربعة –على الأقل- هي ورشة تصنيع جذّابة، وممر لوجستي نوعي، على طرق التجارة الإقليمية، البرية والبحرية.
سرعة توقيع اتفاقات من هذا النوع، خلال أسابيع فقط، يوحي وكأن سباقاً من لاعبين إقليميين ودوليين، يتم على الاستثمار في سوريا. ويبدو هذا السباق في مسافاته الأولى. والملفت، رغم مصادر القلق الناجمة عن غياب التفاصيل، أن السلطات السورية المعنية، منخرطة في هذا السباق، بوتيرة سريعة من التجاوب والانفتاح. سرعة الوتيرة ذاتها تقلق الكثيرين أيضاً. لكن، يمكن تفهّم الحاجة الملحة لهكذا وتيرة سريعة، للنهوض بمعيشة السوريين، من الدرك الكارثي الذي وصلت إليه. إذ أن هناك سباقاً آخر، داخل سوريا، بين نوعين من العوامل، الأول يحث على الانفجار في العلاقة بين مكونات وأطياف الشعب السوري، لا المذهبية والعرقية فقط، بل والمناطقية وتلك المتعلقة بالفروق على صعيد طبيعة التديّن والأعراف الاجتماعية أيضاً. فيما النوع الثاني من العوامل يحث على الاستقرار وإعادة ترميم الشروخ بين السوريين، وإعمار البلاد. نهضة السوريين المعيشية هي المدخل لتثبيط النوع الأول من العوامل التي تحث على الانفجار.
لذا، يمكن تفهّم الوتيرة السريعة –أو ربما المتسرعة أيضاً- من جانب السلطات السورية في توقيع الاتفاقات النوعية. ويبقى التحدّي الأبرز أمام هذه السلطات، لترجيح كفة النوع الثاني من العوامل التي تحث على الاستقرار، هو التحدّي الأمني، المتعلّق بضبط الفصائل والقوى والأفراد المنخرطين داخل تركيبة أجهزة الأمن، كي يخضعوا للقانون، قبل أن يكونوا أدوات إنفاذٍ له.
المدن
————————————–
كالِن في دمشق: التنسيق التركي – السعودي يعيد ترتيب الأوراق السورية/ سمير صالحة
2025.05.25
ما كان مُستبعَدًا بالأمس، بات على طاولة البحث اليوم، وعلى خطِّ العواصم الثلاث: أنقرة، الرياض، ودمشق، حيث تتضاعف جهود دعم القيادة السورية في إعادة بناء الدولة من جديد.
الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كَالِن، إلى دمشق، على رأس وفد أمني رفيع، ولقاؤه بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة، تأتي بالتزامن مع حراك سوري – تركي – سعودي – أميركي مكثف على الخط السوري:
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقرِّر رفع العقوبات عن سوريا فيلحق به العديد من العواصم الأوروبية المؤثرة.
اجتماعات مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة مع وصول وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز إلى واشنطن.
اللقاء الثلاثي الذي تم في تركيا قبل أسبوعين بين وزراء خارجية سوريا وتركيا والولايات المتحدة، والذي ركَّز على رسم خارطة طريق الحوار الأميركي السوري.
تزايد الرغبة العربية التركية الغربية في دعم السلطات السورية على مواصلة المرحلة الانتقالية.
تسريبات عن تقدُّم في الجولة الرابعة من المفاوضات التركية – الإسرائيلية الدائرة في باكو لتجنُّب الصدام بينهما في الأجواء السورية.
مؤشرات إيجابية حول تسجيل اختراق في الحوار غير المباشر بين دمشق وتل أبيب برعاية أذربيجانية ووساطات بعض العواصم العربية.
وهنا يدخل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على الخط مُعلنًا في جلسة استماع لمجلس الشيوخ: “نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بُعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمِّرة تؤدي فعليًّا إلى تقسيم البلاد”.
يواصل روبيو وهو يبرِّر لرئيسه ترمب قرار رفع العقوبات قوله إن دولًا أخرى أرادت إرسال المساعدات إلى إدارة الشرع، لكنها كانت متخوِّفة من العقوبات. فلماذا يتمسك بسياسة “ضربة على الحافر وأخرى على المسمار” ويعود ليردِّد أن كل يوم لا تقوم فيه الحكومة السورية بوظيفتها، سيكون اليوم الذي يجدِّد فيه عناصر داعش قابليتهم وقدراتهم؟ وما الذي يحاول تمريره: تقدير موقف؟ أم قراءة مبنيَّة على معلومات؟ أو تحذير وتهديد؟
ممَّا دفع كَالِن إلى العاصمة السورية هذه المرة هو:
التذكير بأن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم الذي قد تحتاجه إدارة دمشق، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم إدارة السجون والمعسكرات التي تُشرف عليها “قوات سوريا الديمقراطية” باسم التحالف الدولي وتضم آلاف عناصر داعش للسلطة المركزية في دمشق.
وبحث المسار الأمني والسياسي السوري بعد دعوات دمشق الأخيرة الفصائل والمجموعات المسلَّحة لحسم موقفها والالتزام بتسليم السلاح وحل نفسها أو الاندماج ضمن قوّات وزارة الدّفاع.
ورفض احتفاظ “قسد” بسلاحها وضرورة تنفيذ بنود اتفاقية مطلع آذار المنصرم بين الشرع ومظلوم عبدي. وتقييم نتائج اجتماع القامشلي للقيادات والأحزاب والفصائل الكردية الذي يذهب في كثير من توصياته باتجاه معاكس لتفاهمات الشرع – عبدي.
واضح تمامًا أن جهود التشاور والتنسيق بين أنقرة ودمشق تتقدَّم بشكل سريع وبأكثر من اتجاه. الترجمة العملية الأولى لذلك هي الزيارات واللقاءات المكثفة بين الطرفين وعلى أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي لتسهيل خطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
المؤشر الإيجابي الآخر هو التعاون التركي السوري في ملفات خارجية بطابع سياسي واقتصادي، مرتبطة بالمشهد السوري وتسهيل خروج دمشق من العزلة الإقليمية والدولية التي عانت منها لعقود.
الشريك الثالث لهما هو الرياض التي تحرَّكت منذ انطلاق “ردع العدوان” في أواخر تشرين الثاني المنصرم، وبعد تواصل تركي – سعودي بشكل مبكر لتوحيد الجهود والمواقف والسياسات في سوريا. لافت طبعًا أن تقرِّر واشنطن والرياض أن يكون أردوغان حاضرًا، ولو عن بُعد، خلال نقاشات الملف السوري مع الرئيس أحمد الشرع في أثناء زيارته للعاصمة السعودية ولقائه هناك بنظيره الأميركي. ثم أن يتحرَّك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان باتجاه الرياض للقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد مغادرة ترمب بساعات لإجراء تقييم شامل.
المسألة لن تتوقف إذا عند خطوة تسهيل رفْع العقوبات الأميركية عن سوريا، بل هي وصلت إلى مسارعة بعض العواصم الأوروبية لتقليد واشنطن وتفعيل قرارات مشابهة.
فيدان في دمشق من جديد لبحث مسائل سياسية وأمنية عاجلة تُناقش مع واشنطن والرياض ولا بد من تسريع اتخاذ القرارات بشأنها:
سياسة إيران وإسرائيل السورية والتهديدات المحدقة.
موضوع قسد والجمود الحاصل في تنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار بين الشرع وعبدي.
ملف داعش وضرورة فصله عن ملف الوضع القائم في شرق الفرات.
مسألة الانسحابات العسكرية الأجنبية من سوريا والتي تعني أميركا وتركيا وإسرائيل وروسيا بالدرجة الأولى.
كالِن في دمشق لتقويم نتائج مراجعة واشنطن لسياستها السورية بالشق الأمني والعسكري والتحضير لملف قسد وداعش وسط كل هذه المتغيرات والمقاربات الجديدة. لكنه هناك أيضًا تحسُّبًا لسيناريو التفجير الذي قد تبحث عنه أطراف محلية وخارجية متضرِّرة من المشهد الجديد وعلى رأسها تل أبيب وبقايا فلول داعش وجناح الصقور في “قسد”.
تُعوِّل تركيا على نتائج إيجابية ومرضية في الحوار بين دمشق و”قسد”. لكنها متمسكة بحل الهياكل العسكرية وتسليم السلاح والتراجع عن الشعارات السياسية الانفصالية المرفوعة. تريد أن يُترجَم ما يجري في الداخل التركي لناحية الملف الكردي، في شرق الفرات أيضًا خلال الحوار السوري السوري.
تؤكِّد تطورات المشهد السوري بعد إزاحة نظام الأسد أن الأمر لم يعد رقصة ظلٍّ على جدارٍ متحرِّك. الأدوار تتبدَّل بوضوح، تحت سماء مكشوفة لا تُخفي أسرارها، ولا تترك مجالًا للغموض.
وكَالِن لم يأتِ إلى دمشق لالتقاط الصور التذكارية، ولا لحجز مقعد في الصفوف الأمامية انتظارًا لرفع الستار. فأنقرة، بالتنسيق الوثيق مع الرياض، تقف اليوم إلى جانب القيادة السورية الجديدة لكثير من الأسباب السياسية والجغرافية والأمنية، المصحوبة بفهم عميق لما تعنيه محاولات إعادة ترتيب الخرائط في سوريا ومن حولها.
—————————————
تاريخ العقوبات على سوريا: قصة بدأت في دمشق عام 1979 وانتهت بالسعودية/ طارق علي
السبت 24 مايو 2025
يوماً بعد آخر يتغير المشهد في الشرق الأوسط، إلا أن الثابت فيه هو الدور السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي برز بوضوح كلاعب رئيس في الملف السوري، ونزع العقوبات الدولية عن دمشق بضمانات شخصية وسياسية واعتبارية.
بدأ تاريخ العقوبات الأميركية على سوريا منذ عام 1979، بذريعة أنها دولة راعية للإرهاب، ومنذ ذلك الحين استمرت العقوبات وتواترت فصولها، وتدخل في سياقها الاتحاد الأوروبي عام 1986 الذي أزال عقوباته لاحقاً، وكان أشدها قبل الحرب السورية الأخيرة التي بدأت عام 2011، هي العقوبات الأميركية عام 2003، على خلفية دعم تمرير الإرهابيين للقتال في العراق، ومن ثم عام 2004 حول قضايا الوجود السوري في لبنان وشرعيته، الذي كان مستمراً منذ عام 1976.
لكن بعد عام 2011 بدأت تأخذ العقوبات منحى تصاعدياً ملفتاً وقاسياً وصارماً، وهذه المرة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وجامعة الدول العربية ودول كثيرة أخرى، وكان أكثرها قسوة “قانون قيصر” عام 2020، ومكافحة “الكبتاغون” عام 2023، ومحاربة التطبيع عام 2024، ليبلغ مجموع العقوبات الدولية على سوريا نحو 2500 عقوبة تشمل معظم مناحي الحياة اليومية.
تجميد العقوبات
ظلت هذه العقوبات منذ إقرارها بمثابة قيد يحطم أعناق السوريين، في وقت نجح نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في التملص منها والالتفاف عليها لتحقيق توازنات وأغراض شخصية بحتة، إلى أن سقط النظام أواخر العام الماضي، وجاءت سلطة جديدة إلى رأس الهرم، ومع وصولها انتفت ضرورة وجود هذه العقوبات التي جرى إقرارها على نظام رحل، وهو ما تحقق بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من السعودية تعليقه العقوبات على سوريا، بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، برعاية مباشرة ووساطة كبرى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تجمع المصادر السياسية أنه بذل جهوداً جبارة لإتمام الاتفاق الذي وصف بالتاريخي.
والسؤال كيف سينعكس رفع العقوبات على حياة السوريين؟ وما المدد الزمنية التي يمكن أن يتحقق من خلالها؟ مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين العقوبات التي صدرت على صورة أوامر تنفيذية من رؤساء أميركا ويحق لهم إلغاؤها مباشرة، وبين تلك التي صدرت عن الكونغرس بمراسيم تشريعية وقد تستغرق إزالتها وقتاً طويلاً للغاية وتشريعات جديدة؟ وما المقابل المطلوب من سوريا اليوم لتنفيذ الاتفاق تحت عباءة السعودية الضامنة التي برزت على المستوى الإقليمي والعالمي صانعة للحلول في هذا الإطار؟
تهمة الإرهاب
أرخت العقوبات الأميركية على سوريا، التي وضعتها واشنطن على لائحتها السوداء كونها دولة راعية للإرهاب، بثقلها السياسي والاقتصادي على البلاد. والمقصود بدعم الإرهاب هو دعم فصائل فلسطينية ولبنانية معادية لإسرائيل، بل واستضافتها وافتتاح مقار ومعسكرات تدريب لها، وشملت العقوبات المساعدات العسكرية والمالية وحظر التصدير لبعض المقتنيات، ومنها ما كان كماليات أو أساسيات.
آنذاك كان الرئيس الراحل حافظ الأسد على رأس السلطة، وفي الفترة الأولى من العقوبات لم يتغير شيء تقريباً داخل البلاد، وبدأت أواسط الثمانينيات تتضح فعلياً تداعيات تلك العقوبات.
ويستذكر الناس، في ذلك الوقت، أنهم مروا بفترات كان يصعب فيها الحصول على علبة مناديل، أو عبوة زيت وخلافهما، لكن العلاقة الاستراتيجية التي جمعت الأسد بالاتحاد السوفياتي، واعتماده على إعادة بناء قطاع الاقتصاد الداخلي، متكئاً على تجار دمشق وحلب، مكنته من الالتفاف على تلك العقوبات.
وحذا الاتحاد الأوروبي حذو أميركا وأقر حزمة عقوبات واسعة عام 1986، لكنه أزالها في أواسط التسعينيات.
فصل جديد
بدأ فصل جديد من العقوبات القاسية، كان على رأسها عقوبات عام 2003 الأميركية المرتبطة باتهام نظام بشار السد بدعم المقاتلين العراقيين في مواجهتهم مع الأميركيين، وتسهيل مرور الإرهابيين من سوريا إلى العراق، بل وفتح أبواب السجون حيث كانوا ينزلون في دمشق، فكان قانون “محاسبة سوريا” الذي شمل قيوداً صارمة في مجالات مالية ومصرفية، وأخرى تتعلق بقطاعي الطيران والاتصالات وحظر توريد مستلزماتهما.
وفي عامي 2004 و2005 عوقبت سوريا من جديد على وجودها في لبنان، واتهامها بارتكاب جرائم هناك، وتالياً الضغط عليها للخروج من هذا البلد، مع استخدام قرار أممي ملزم لذلك عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، وترجم هذا القرار بانسحاب جيش النظام السوري خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، اللذين تبعا الاغتيال.
نقطة التحول
بقي نظاما الأسد الأب (حافظ) والابن (بشار) يناوران بين تلك العقوبات وينجحان في تخطيها غالباً، إلى أن اندلعت الثورة السورية عام 2011، فبدأ النظام بتلقي العقوبات جملة وتفصيلاً من دول العالم، واستهدفت العقوبات للمرة الأولى رئيس الجمهورية وكبار مسؤوليه وشخصياته، وحاصرت قطاعات النقل والنفط والغاز والبنوك والاستثمار، مما أدى إلى شلل فعلي في الاقتصاد الوطني.
عاماً تلو آخر كانت تزداد العقوبات وتتسع دائرة الدول المشاركة فيها، وصولاً إلى عام 2020، إذ كان نقطة التحول في مصير حكم عائلة الأسد مع إقرار حزمة “قانون قيصر” الأميركي، الذي لم تشهد البلاد له مثيلاً في الصرامة والشدة من قبل، وشمل عقوبات بالجملة على شركات وكيانات ومؤسسات وأفراد، وتجميد أصول أموال عامة، وحظر التعامل مع أية جهة أو شخصية فردية أو اعتبارية، تتعاون مع نظام السد، وفي مختلف النواحي، في مقدمها الطاقة والتمويل والبناء والطيران والسلاح، كما أتاحت بنود القانون ملاحقة أية شركة أجنبية أو مصرفية أو شخصية تتعامل مع نظام الأسد.
في عام 2023 توج “قانون قيصر” بقانون مكافحة تجارة “الكبتاغون”، من خلال اتهام سوريا بأنها أصبحت المركز الدولي لإنتاج وتصدير المخدرات إلى الخليج ودول العالم، وأضيفت أسماء شخصيات جديدة على لائحة العقوبات من بينها رجال أعمال وأفراد من عائلة الأسد.
في عام 2024 صدر قانون عقابي جديد يهدد أية دولة تحاول تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد تحت اسم مشروع “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، ويشمل القانون عقوبات مشددة على كل حكومة أو كيان رسمي يدعم الأسد اقتصادياً أو سياسياً أو غير ذلك.
وبلع عدد العقوبات على سوريا حتى تاريخ سقوط النظام أواخر يناير ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2024 نحو 2500 عقوبة، وهي نسبة من أعلى معدلات العقوبات التي فرضت على دولة حول العالم في العصر الحديث، وبمجملها عاقبت التحويلات المالية والمساعدات التنموية أيضاً، فصارت سوريا من أكثر دول العالم التي ترزح تحت حصار اقتصادي خانق.
من دفع الثمن؟
فعلياً لم يدفع بشار الأسد وأسرته والمحيطون به ثمن تلك العقوبات، بل كانوا على الدوام يمتلكون ممرات خلفية للحصول على ما يريدون، وكانوا أكثر انغماساً في تجارة المخدرات وجباية الأموال واكتنازها وتأسيس إمبراطورية مالية كبرى، في حين دفع الشعب السوري ثمن تلك العقوبات على مدار عقود.
يارا خزامي والدة لثلاثة أطفال في دمشق، تقول إن العقوبات حاصرت قوت يومهم، “ولم تكن تؤثر في النظام بصورة مباشرة، لأنها لم تجوعه أو تجعله يفقد امتيازاته، ولم تثنه حتى عن بطشه في وجه شعبه”، في حين عجزت أياماً طويلة، عن تأمين الدواء والحليب لأطفالها والأسعار التهبت، وأكدت أنها “سمعت عن أناس كانوا يموتون لأنهم لا يملكون ثمن العلاج”.
وفي القطاع التعليمي يبين الأستاذ المدرس جهاد ربيعة أن مدارس سوريا صارت تفتقد لأبسط المستلزمات، وبدأ يتسرب الأطفال على إثر الجوع والفقر والحاجة تاركين مقاعد الدراسة نحو العمل المضني أو الهجرة البعيدة وربما الخيام، في حين عاش من تبقى منهم في حال خوف مما ينتظرهم مستقبلاً.
أحمد عبدالرحمن، لاجئ سوري، كان مقيماً في لبنان، وعاد لبلده عقب سقوط نظام السد، يروي أن أموراً كثيرة تغيرت، حيه مهدم، منزله كذلك، لا فرص عمل ولا أفق لمستقبل، لذا قرر العودة ثانية من حيث جاء.
في الوقت ذاته تستبشر جميلة سرور من رفع العقوبات، وهي طالبة جامعية في كلية الهندسة، تعيش مع أسرتها في منزل صغير، إذ يعانون دفع إيجاره الشهري، ومن خدمات الاتصالات والمواصلات وارتفاع الأسعار، آملة أن ينتهي كل ذلك سريعاً.
في الجانب الصحي تفتقد المستشفيات والمستوصفات معظم المعدات والأدوية، وتبدأ رحلة البحث عن البدائل، بحسب الممرضة نورهان عبدالحي، التي تقول “البدائل ليست دائماً مجدية، ومعدلات الموت لدينا مرتفعة، نعاني حتى على صعيد عدد سيارات الإسعاف، وعلى صعيد تقديم الإسعافات الأولية نفسها، وذلك كله بسبب العقوبات”.
المقابل المطلوب
“لا شيء في السياسة يأتي بالمجان، دائماً هناك مقابل”، يقول الأستاذ في العلوم السياسية رائد جمال الذي أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض مطالبه أمام الشرع الذي وعد بتنفيذها ليصار إلى “تجميد” العقوبات ومراجعتها، وعن أبرز تلك المطالب يقول الأستاذ الجامعي “لا شك أنه كان هناك أكثر من مطلب حيوي وفعال ويحتاج إلى عمل حقيقي، لكنني سأكتفي بذكر أبرز ما جرى طلبه من القيادة السورية الجديدة، وهو أن تتولى إدارة الشرع مسؤولية مراكز احتجاز مسلحي داعش وعائلاتهم في الشمال الشرقي من سوريا، التي ما زالت حتى الآن تحت إشراف قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، وهو بحد ذاته ملف دولي مقلق لتداخل جنسيات المعتقلين وغياب آلية واضحة للترحيل أو المحاسبة، كذلك جرى طلب فتح المجال الجوي لأميركا لمواجهة داعش ومساعدتها في ذلك بصورة تامة”، ويضيف “من بين المطالب كان ترحيل عناصر إرهابية فلسطينية من الأراضي السورية، إضافة إلى أهم بند، هو بمثابة الاختبار الصارم للإدارة الجديدة ومتعلق بترحيل المقاتلين الأجانب كافة من سوريا، الذين يفوق تعدادهم 7 آلاف، ومن بين المهم في المطالب هو توقيع سوريا على اتفاقات أبراهام مع إسرائيل”.
ريادة الدور في المنطقة
يوماً بعد آخر يتغير المشهد في الشرق الأوسط، إلا أن الثابت فيه هو الدور السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي برز بوضوح كلاعب رئيس في الملف السوري ونزع العقوبات الدولية عن دمشق بضمانات شخصية وسياسية واعتبارية، وبطبيعة الحال فهذا الدور لم يأت من فراغ، بل كان حصيلة جهود دبلوماسية مركزة وقراءات استراتيجية متوازنة تعكس أهمية الرياض بين عواصم العالم كضامنة للاستقرار الإقليمي.
أخذ ولي العهد السعودي على عاتقه لعب دور الوسيط بين أميركا وسوريا، ونجح في أقل من ستة أشهر من إزاحة العقوبات عن كاهل الدولة الوليدة وفق رؤية ترتبط بالمقام الأول بالحالة الإنسانية التي تعيشها دمشق، وتمهيداً لإعادتها لدورها الإقليمي في المنطقة بعد سنوات طويلة من المشقات السياسية والتقارب والتنافر والتنافس مع المحور الإيراني – الروسي، اللذين جاء بهما الأسد عوضاً عن امتداده الطبيعي ضمن الحضن العربي.
تجمع الآراء السياسية أن الشخصية القيادية لولي العهد السعودي كانت الفيصل في إتمام اللقاء فالاتفاق، ونجحت المملكة في تذليل العقبات وإتمام ما كان يبدو مستحيلاً قبل اللقاء السوري – الأميركي.
——————————-
خبراء: رفع العقوبات عن سوريا يعجّل إعادة بناء اقتصاد البلاد/ أحمد العكلة
25/5/2025
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
وأكدت كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن التكتل الأوروبي يهدف إلى “مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة، مسالمة، تضم جميع الأطياف”، مشددة على التزام أوروبا بدعم السوريين على مدى السنوات الماضية.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن القرار يشمل رفع العقوبات التي كانت تستهدف قطاعات اقتصادية ومصرفية محددة، وذلك بهدف دعم تعافي البلاد، دون أن يشمل ذلك رفع العقوبات العسكرية أو تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ورحّبت سوريا برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما.
أبعاد القرار الأوروبي
وفي تصريح لـ “الجزيرة نت”، رأى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن القرار الأوروبي فرصة لإعادة تفعيل النشاط التجاري واللوجستي، خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير للمواد الإنسانية والطبية والتجهيزات الصناعية.
وأكد أن تعزيز التبادل التجاري عبر القنوات الرسمية من شأنه أن يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء والمعابر غير القانونية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
مع ذلك، حذر علوش من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي للقرار يرتبط بمدى شموليته وآليات تنفيذه، إضافة إلى مواقف الدول المجاورة التي تُعد محاور رئيسية لعبور البضائع.
وأضاف أن تنفيذ القرار يتطلب تنسيقاً فنياً واسعاً مع شركاء إقليميين ودوليين، لضمان استفادة المعابر البرية والمرافئ البحرية من هذا الانفتاح المنتظر.
كما كشف علوش عن وجود خطط لتحديث قوائم المواد المسموح باستيرادها وتصديرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مشيراً إلى أن هناك تقييماً فنياً جارياً للبنية التحتية في المرافئ والمعابر تحسباً لازدياد متوقع في النشاط التجاري.
موقف المعارضة السورية
من جانبه، قال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، إن العقوبات الأوروبية كانت رداً مباشراً على القمع الذي مارسه النظام السوري منذ عام 2011، وشملت قطاعات النفط والمصارف وتصدير التكنولوجيا، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الأوروبية أخيراً يعكس تفاعلاً مع سياسة الولايات المتحدة، التي كانت قد أعلنت قبل أيام نيتها تخفيف بعض عقوباتها، معتبراً أن السياسة الأوروبية تأتي في إطار التناغم مع التوجه الأميركي.
وأضاف أن العقوبات الأميركية لا تزال الأشد تأثيراً على النظام.
ووفقاً لغانم، فإن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة “جهد سوري منظم”، مؤكداً أن “السوريين نجحوا في تحقيق ما كان قد يستغرق سنوات في بضعة أشهر فقط”.
وأوضح أهمية الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تبقى الفاعل الأساسي في ملف العقوبات المفروضة على النظام.
فرص اقتصادية واعدة
من جهته، اعتبر الدكتور خالد تركاوي، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن القرار الأوروبي “فرصة تاريخية” لتعافي الاقتصاد السوري، خاصة بإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يتيح للبنوك السورية استئناف أنشطتها ويُسهّل عمليات التحويل المالي والائتماني.
وأشار تركاوي إلى أن هذا الانفتاح يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، ويساهم في تحسين إيرادات الدولة من التجارة والضرائب، ما يقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ولفت إلى أن سوريا تُعد “أرضاً خصبة للاستثمار” في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، موضحاً أن إزالة القيود القانونية والمصرفية سيعزز من جاذبية السوق السورية.
وعلى المستوى المعيشي، يرى تركاوي، أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع، وتوفير فرص عمل عبر مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، مما قد يشجع على عودة بعض السوريين المغتربين إلى بلادهم.
واختتم تركاوي بالتأكيد على أن استقرار سعر صرف الليرة السورية وتراجع معدلات التضخم سيكونان من أبرز النتائج المتوقعة للقرار الأوروبي، مما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للنمو والتنمية.
خلفية العقوبات الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام السوري في مايو/أيار 2011، مستهدفاً شخصيات وكيانات مرتبطة بعمليات القمع، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة والتعامل مع البنك المركزي السوري.
وفي وقت لاحق، توسعت العقوبات لتشمل الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد أسرته ودائرته المقربة، حيث تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.
كما شملت العقوبات حظرًا على تصدير النفط والمعادن الثمينة، فضلاً عن قيود متنوعة على التعاملات المالية. وبحلول منتصف عام 2012، كانت قائمة العقوبات قد اتسعت لتضم أكثر من 120 شخصية و40 كياناً، معظمها على صلة مباشرة بالنظام السوري. وكان الهدف المُعلن من هذه العقوبات يتمثل في حرمان النظام من الموارد المالية التي قد تُستخدم في قمع المدنيين، مع الحرص على عدم المساس بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.
المصدر : الجزيرة
————————————
النفط والبنوك ومشاريع الإعمار أبرز المستفيدين من تخفيف العقوبات عن سورية/ جلنار العلي
25 مايو 2025
في خطوة أولى لتنفيذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، أصدرت وزارة الخزانة، أول من أمس الجمعة، قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على الدولة التي تعاني انهياراً اقتصادياً ودماراً واسعاً خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، الأمر الذي رحبت به الحكومة المؤقتة في البلاد، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سورية الطبيعية في الإقليم والعالم”، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى استفادة قطاعات حيوية، على رأسها النفط والبنوك والمبادلات التجارية وجذب الاستثمارات، ما يساعد في تعافي البلاد اقتصادياً وتحسن قيمة عملتها المتهاوية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، “الرخصة العامة 25 لسورية” والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن هذه الرخصة أن تسهم في “فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص”. وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، “وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سورية”، وفق البيان الصادر عن الوزارة. وأضافت أن الإعفاء “سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سورية”.
وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف مايو/أيار الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سورية. وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. ووفق وزارة الخزانة، فإن هذا الإجراء مجرد “جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سورية بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”.
وأكدت الخزانة الأميركية أن “الرخصة العامة 25 لسورية” تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/أيار الحالي بشأن وقف العقوبات على سورية. مشيرة إلى أن تخفيف العقوبات مُنح “للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية”. وأكدت أن الولايات المتحدة “ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سورية”. وصرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على منصة إكس بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان “تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية”. وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. ويأتي رفع العقوبات في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود، إذ تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمار البلاد بنحو 400 مليار دولار.
ورغم توقعات المحللين بأن الآثار المباشرة لرفع العقوبات قد تكون محدودة في الوقت الراهن، لافتين إلى أنها تتطلب اتخاذ السلطات إجراءات وتدابير عدة منها تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة، إلا أنهم أكدوا أهميتها في تعافي الاقتصاد تدريجياً والخروج من عثرته. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، مستفيدة من حالة التفاؤل، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان قد لامس عتبة 13 ألفاً.
إعادة الحياة إلى جوهر بنية الاقتصاد
الباحث الاقتصادي محمد السلوم، يشير في تصريحه لـ”العربي الجديد” إلى أن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي السوري، المصرف الصناعي، البنك التجاري السوري، شركة المحروقات، الشركة العامة للنفط، شركة بانياس لتكرير النفط، ووزارة السياحة، لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها، لافتاً إلى أن الاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي.
فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي السوري على وجه الخصوص، يُفتح الباب أمام دمشق لاستعادة جزء من دورها في شبكة المدفوعات الدولية، وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن. وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية، وفق السلوم.
أما بالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري، فاعتبر الباحث الاقتصادي السوري، أن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة، وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب.
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل، وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج.
ولفت السلوم إلى أن الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لا سيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية. ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية.
واعتبر أن كل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية، ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج.
إصلاحات هيكلية لجذب استثمارات مستدامة
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد في تصريحه لـ”العربي الجديد” إن “رفع العقوبات يفتح باباً لتعافي الاقتصاد السوري، لكن نجاحه مرهون بتحقيق استقرار سياسي وشفافية في الإدارة، إذ تحتاج سورية إلى إصلاحات هيكلية مثل تحديث النظام المصرفي ومكافحة الفساد لجذب استثمارات مستدامة، خاصة في ظل التحديات المتراكمة منذ عقود”.
وأشار إلى أن تخفيف العقوبات من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز، إذ سيتمكن القطاع من تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الدولية، مما يُدِر عائدات كبيرة بالدولار تُستخدم لإعادة الإعمار وتمويل الخدمات العامة، كما سيُسمح بإصلاح المنشآت النفطية المتضررة كالمصافي واستئناف الإنتاج، مما يعزز الطاقة الإنتاجية ويوفر فرص عمل، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الدول الخارجية، مما يُحسّن الاستقرار الاقتصادي ويقلل الضغوط السياسية.
أما بالنسبة للتأثير على المصارف، فيرى محمد، أن هذا الأمر سيساهم في استقرار سعر الصرف، إذ سيستعيد المصرف المركزي الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج (مثل الذهب والعملات الأجنبية)، مما يعزز احتياطاته ويساهم في استقرار الليرة السورية، ناهيك عن تسهيل التجارة الخارجية من خلال إعادة اندماج المصارف السورية في النظام المالي العالمي ما سيُسهل التحويلات المالية الدولية، ويقلل تكلفة الاستيراد. كما يمكن من خلال استثناء هذه الكيانات من العقوبات جذب الاستثمارات، إذ سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل،
وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن عدم شمول المصارف الخاصة في قرار تخفيف العقوبات، ربما يرجع إلى الاشتباه بتعامل بعضها مع شبكات تمويل غير مشروعة (مثل تهريب النفط أو المخدرات) أو ارتباطها بشخصيات مُستهدفة بالعقوبات، مما يمنع رفع القيود عنها، علماً أن لهذا الأمر تأثيرات سلبية كاستمرار عزلة هذه المصارف وصعوبة التحويلات المالية الدولية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وعرقلة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عمل بلا خوف في مشاريع إعادة الإعمار
وحول تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، فيعتبر محمد أنه يمكن للشركات الأجنبية من خلال ذلك المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار (مثل الطاقة والمياه) دون خوف من عقوبات، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود ومياه الشرب عبر استيراد المعدات اللازمة، مما يُخفف الأزمة الإنسانية، كما يمكن إقامة مشاريع قصيرة الأجل خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وإبرام عقود استثمار سريعة، مشيراً إلى أن هذه الفترة المؤقتة هي بمثابة اختبار لنوايا الحكومة الجديدة لمراقبة التزام سورية بشروط رفع العقوبات الدائمة (مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات).
من جهته، يؤكد الباحث السياسي وائل علوان، أن سورية تنظر اليوم بعين إيجابية وبمزيد من التفاؤل والأمل بكل خطوة للوصول إلى الاستقرار، معتبراً في تصريحه لـ”العربي الجديد” أن الخطوات تبدو اليوم سريعة على مستوى الثقة بالنظام السياسي الجديد والإدارة الجديدة وقدرتها على تحقيق الاستقرار، كما أن الإجراءات تتم بنفس التسارع الذي يتم به القرار السياسي، وهذا يعني أن سورية ستلمس قريباً مفاعيل رفع العقوبات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا القرار كان مهماً جداً لتحقيق البيئة المناسبة للاستقرار لبناء سورية الجديدة، كما أن ذلك يعطي مسؤولية كبيرة للحكومة من المجتمع الدولي لتثبت أنها قادرة على ضبط الأوضاع وخلق استقرار أمني وسياسي واجتماعي، ومشاركة جميع المكونات السورية، أي أن الدول ستراقب أداء الحكومة بشكل أكبر.
————————
هل يعود اللاجئون إلى سوريا بعد رفع العقوبات الدولية عنها؟/ فاطمة عبود
2025.05.24
هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري موزعين في أصقاع الأرض، لكلِّ واحد منهم حكايته التي تبدأ غالباً بمجزرة أو اعتقال أو تهديد، ولا تنتهي إلا بحقيبة صغيرة ووداع طويل، ومع كلِّ تطور سياسي أو اقتصادي يلوح في الأفق، يعود السؤال القديم ليطفو من جديد: هل انتهت رحلة شتات الشعب السوري؟ وهل سنعود إلى سوريا؟
في الظاهر، يبدو أنَّ رفع العقوبات حدث إيجابي، وهو كذلك، إذا ما نظرنا إليه من جانب واحد، إذ كانت العقوبات، طوال سنوات الحرب، أحد الأسباب الرئيسة لانهيار الاقتصاد السوري؛ فالأسعار تضاعفت بشكل جنوني، الكهرباء أصبحت رفاهية، المستشفيات تهالكت خدماتها، والمصانع توقفت عن الإنتاج.
وفي الخارج، كان السوريون يتحدثون دائماً عن المعاناة هناك، حيث لم يكن سهلاً أن يشاهدوا أهلهم الذين ما استطاعوا الخروج من سوريا يصطفون في طوابير الخبز، أو يتبادلون الأدوية المهربة في الأسواق السوداء، وغير ذلك الكثير.
الآن، وبعد أن سقط النظام الأسدي البائد، ورفعت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بدأت الأنظار تتَّجه نحو مستقبل آخر؛ لأنَّ الاستثمارات قد تعود، والبنوك قد تفتح أبوابها، والمساعدات الدولية ستتدفق، والشركات ستبدأ بإعادة بناء ما دمَّره القصف، ولا شك أنَّ هذه الصورة مغرية بالعودة إلى الوطن، لكنَّ كثيراً من السوريين لا يستطيعون بناء قراراتهم اعتماداً على وعود اقتصادية فقط. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل يكفي رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا حتى يعود السوريون إلى الوطن؟ هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بشكل مباشر أو سطحي؛ لأنَّه مرتبط بعوامل متشابكة، تتعلَّق بالواقع السياسي، والظروف الاقتصادية، والوضع الأمني، ومدى الثقة في البيئة التي ستتشكّل بعد نهاية النظام.
وخلال السنوات الماضية، شكّلت العقوبات الدولية أداة رئيسة للضغط على النظام السوري الساقط، إذ استخدمت كوسيلة غير عسكرية لمحاصرة النظام، والحدِّ من قدرته على الاستمرار في قمع الشعب السوري، أو تمويل عملياته العسكرية. وقد طالت هذه العقوبات قطاعات حيوية وحساسة، من أبرزها المصارف والبنوك، والطاقة والنفط، والتجارة الدولية، والتحويلات المالية، ما أدى إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي وتقييد حركتها الاقتصادية بشكل كبير. ورغم أنَّ الهدف المُعلن لتلك العقوبات كان استهداف منظومة الحكم والدائرة الضيقة المحيطة به، إلا أنَّ الانعكاسات العملية تجاوزت ذلك، لتطول قطاعات الحياة اليومية للمواطنين السوريين الذين كانوا يجدون صعوبة في تأمين المواد الغذائية الأساسية والأدوية، التي أصبحت إمَّا نادرة أو باهظة الثمن. كما أثّرت القيود المفروضة على التحويلات المالية سلباً على أسر كثيرة كانت تعتمد على مساعدات الأقارب في الخارج لتأمين احتياجاتها.
لذلك فإنَّ رفع العقوبات، بالنسبة للسوريين في الخارج، لا يمثِّل ضماناً مباشراً أو كافياً لاتخاذ قرار العودة، فقرار كهذا لا يقوم فقط على توفر الظروف الاقتصادية أو إعادة فتح قنوات الاستثمار والمساعدات، بل يعتمد على عوامل أعمق تتعلق بالأمان، والمحاسبة، وإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة؛ لأنَّ غالبية اللاجئين السوريين غادروا البلاد نتيجة لانعدام الأمان الشخصي، والملاحقة السياسية، والانهيار الشامل في مؤسسات الدولة، وبالتالي، فإنَّ عودتهم مرهونة بوجود نظام سياسي مختلف جذرياً يضمن عدم تكرار الانتهاكات السابقة. السوري في الخارج يحتاج إلى ضمانات حقيقية بعدم التعرض للمساءلة على خلفية مواقفه السياسية، كما يحتاج إلى تأكيدات بأنَّه لن يكون عرضة للاعتقال، أو التجنيد الإجباري، أو للممارسات الأمنية التعسفية التي كانت السبب المباشر في نزوح الملايين.
بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ اللاجئ الذي عاش لسنوات في دولة مضيفة ونجح، رغم التحديات، في بناء حياة مستقرة نسبياً، من خلال الحصول على العمل، والتعليم، وتأمين مستقبل أولاده، لن يختار العودة بسهولة إلى وطن ما زال يعيش حالة من عدم اليقين، ما لم يكن متأكداً من أنَّ بلاده أصبحت قادرة على تأمين حياة كريمة، مستقرة، وذات أفق اقتصادي واجتماعي واضح. كما أنَّ العودة في ظل ظروف غامضة وغير مستقرة قد تعني تكرار تجربة الخوف، والحرمان، والاضطهاد التي دفعتهم إلى اللجوء أصلاً، وهو ما يجعل كثيراً منهم يفضلون البقاء في بلاد اللجوء رغم صعوباتها، بدلاً من المجازفة بالعودة إلى بيئة ما زالت محفوفة بالمخاطر.
إنَّ رفع العقوبات قد يشجّع على تحريك عجلة الاقتصاد، ويدفع باتجاه استعادة نشاط البنية التحتية، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتدفق المساعدات الدولية، لكنه يظل إجراء تقنياً ما لم يُربط بخطة سياسية واضحة تشمل العدالة الانتقالية، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة قانونية تضمن الحريات العامة والمساءلة، فعودة اللاجئين السوريين تتطلب أولًا ثقة في الحكومة الجديدة، وثانياً إشرافاً دولياً يضمن التزام السلطة الانتقالية بتنفيذ خارطة طريق متفق عليها، وثالثاً إجراءات عملية تشمل إصدار قوانين للعفو، وإنشاء لجان لحقوق الإنسان، وتقديم تعويضات للمتضررين.
من هنا، فإنَّ رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط النظام يجب ألا يُنظر إليه كعامل حاسم في عودة اللاجئين، بل كجزء من سلسلة تحولات سياسية ومؤسساتية شاملة، وهذا يتطلب بناء دولة جديدة تتجاوز البنية الأمنية التي حكمت البلاد لسنوات طويلة، وتمنح المواطنين حقهم في المشاركة، والمساءلة، والحماية القانونية، ومن دون ذلك، فإنَّ رفع العقوبات سيبقى خطوة ناقصة، وقد يتحول إلى فرصة ضائعة إن لم يُستثمر ضمن مشروع وطني شامل يعيد بناء الدولة والمجتمع على أسس جديدة.
تلفزيون سوريا
—————————-
احتضان ترامب للرئيس السوري الشرع يعيق استراتيجية إسرائيل التوسعية في سوريا
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده مايكل شير، قال فيه إن تقارب ترامب مع سوريا يعقد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
ومنذ لقاء ترامب مع الرئيس السوري الجديد، تراجعت الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد. وقالت الصحيفة إن إسرائيل شنت أكثر من 700 غارة على سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، بما في ذلك ضرب مواقع قريبة من القصر الرئاسي في دمشق. وزعمت إسرائيل أن الهدف من هذه الغارات كان منع الأسلحة الوقوع في أيد معادية والحد من قدرة الحكومة الجديدة على ترسيخ قوتها في جنوب سوريا.
وقال أوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “هذا بالتأكيد درس من جنوب لبنان”. وأشار أراد الناقد حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السنوات التي قضتها إسرائيل في مواجهة الجماعات الفلسطينية وحزب الله في جنوب لبنان، حيث شنت هجمات على شمال إسرائيل.
كما وصفت إسرائيل الحكومة السورية الجديدة، التي يترأسها زعيم كان مرتبطا مرة في القاعدة بأنها “متطرفة”. ولكن بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية في 2 أيار/مايو قرب القصر الرئاسي في دمشق، قلب الرئيس ترامب عقودا من السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب باجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وإعلانه عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.
وقال ترامب إن لدى الشرع “فرصة حقيقية لإعادة بناء البلاد”، بعد حرب أهلية مدمرة دامت قرابة 14 عاما.
ومنذ ذلك الاجتماع في 14 أيار/مايو، توقفت الضربات الإسرائيلية على سوريا تقريبا. ومع أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل إلا أن التقارب الأمريكي- السوري واحتضان الشرع لم يمنحا الرئيس السوري طوق نجاة غير متوقع فقط، بل وقوضا على ما يبدو جهود الحكومة الإسرائيلية المتشددة لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحكومة الجديدة لمنع صعود جار آخر معاد لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن كارميت فالنسي، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب “لدى إسرائيل شكوك عميقة حول نيته وصورته البراغماتية التي يحاول تقديمها”، في إشارة للشرع.
وقبل منح ترامب الثقة للشرع، حاول نتنياهو وقادته الكبار حرمان الحكومة الجديدة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسلحة الثقيلة التي جمعها نظام الأسد على مدى عقود من حكمه. وقالت فالنسي: “كان الجزء الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية موجهًا ضد أسلحة استراتيجية كان الجيش السوري السابق يملكها”، مضيفةً أن الحكومة الإسرائيلية يبدو الآن أنها بدأت في إيجاد طرق لتجنب المزيد من المواجهة. وقالت: “كل هذا يشير إلى اتجاه لخفض التصعيد ومنع الصراع، واستعداد أكبر لفتح حوار مع النظام السوري”.
وبرر المسؤولون الإسرائيليون دوافعهم للهجوم على سوريا، بالدروز، حيث يعيش منهم 150,000 في إسرائيل ويخدمون في الجيش الإسرائيلي. وفي بيان للجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أكد مساعدة المجتمعات الدرزية في سوريا وأنها “نابعة من التزام لإخواننا الدروز في إسرائيل”. ويعيش دروز سوريا في السويداء ونادرا ما شكلوا تهديدا على إسرائيل.
وفي نهاية نيسان/أبريل، عندما اندلعت اشتباكات طائفية عنيفة بين ميليشيا درزية وقوات مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، عرضت إسرائيل مساعدة الدروز. وصور القادة الإسرائيليون الغارة قرب القصر الرئاسي بأنها تحذير للشرع لوقف الهجمات على الدروز، مع أن دوافع الجهات الأخرى على سوريا خلال الأشهر الماضية تتجاوز دعم الدروز.
وبدأت إسرائيل هجماتها على سوريا حالا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر. ونفذت في أسبوع واحد 450 غارة تقريبا. وأدت الهجمات إلى تدمير البحرية السورية بأكملها والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف في جميع أنحاء البلاد، حسب قول الجيش الإسرائيلي.
كل هذا مع أن الحكومة السورية الجديدة لم تهاجم إسرائيل منذ توليها السلطة، وقالت إن البلاد تعبت من الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول.
وعليه، فغصن الزيتون الذي قدمه ترامب للشرع يعقد الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا، وهو أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط. وقال يعقوب أميدرور، وهو مستشار سابق آخر للأمن القومي لنتنياهو وزميل في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي: “ما لا نريده في سوريا هو نسخة أخرى من الحوثيين”.
ويشكك نتنياهو ومن حوله في مواقف الشرع وحكومته ويعتقدون أنها ستتطور نحو حكومة إسلامية معادية لإسرائيل.
وسخر جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في آذار/مارس من فكرة ظهور حكومة عقلانية في سوريا وقال إنها فكرة “سخيفة”، مضيفا أن الشرع وجماعته “جهاديون وسيظلون جهاديين حتى لو لبس بعض قادتهم البدلات”. إلا أن الهجوم الواسع النطاق على سوريا أثار انتقادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى الشرع في منتصف أيار/مايو. وقال ماكرون عن إسرائيل: “لا يمكنك ضمان أمن بلدك بانتهاك سلامة أراضي جيرانك”. وهناك البعض داخل إسرائيل يقولون إن حملة عسكرية منسقة لن تكون في مصلحة إسرائيل، على المدى البعيد.
ويعتقد محللون عسكريون أن الهدف وراء التوسع في سوريا هو ضمان أمن الجولان، حيث استولت إسرائيل على مناطق واسعة من جنوبي سوريا. وهناك عامل آخر وهو الحد من تأثير تركيا في سوريا. ولكن قد تكون جهود الولايات المتحدة للتقارب مع سوريا هي التي تعيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.
————————————
التهريب وتصاعد نشاط «الدولة»: التحدي الأمني يهدد استقرار سوريا/ منهل باريش
يثير تنامي نشاط تنظيم «الدولة» قلقًا متزايدًا، حيث أظهر التنظيم قدرة على الانتقال من البادية السورية إلى الحواضر المدنية، وساهم ضعف الأجهزة الأمنية في تسهيل هذا التحول.
قُتل عنصران من الجيش السوري على يد الحرس الروسي في قاعدة حميميم العسكرية بعد هجومهما على القاعدة. ووفقًا لمصدر أمني سوري، نقلت القوات الروسية جثتي القتيلين إلى داخل المطار العسكري، الذي يُعدّ مقرًا لقيادة القوات الروسية العاملة في سوريا. ورفضت القوات الروسية تسليم الجثتين إلى جهاز الأمن العام حتى مساء الجمعة.
وكشفت صحيفة «القدس العربي» هوية أحد المهاجمين، وهو الشاب عمار مصطفى الحسن «الحركوش»، المنحدر من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي. يُشار إليه أيضًا بلقبَي «أبو بكر الأنصاري» أو «أبو بكر السفراني». وعلى عكس ما أوردته بعض الوكالات الإخبارية، فإن القتيل كان عنصرا عاديا في الجيش السوري، وليس مدربا في الكلية البحرية على الساحل السوري. كما تبين أنه كان منضمًا سابقًا إلى حركة «أحرار الشام» الإسلامية، قبل أن ينضم إلى الجناح العسكري لهيئة «تحرير الشام» قبيل معركة «ردع العدوان».
وعلمت «القدس العربي» بأن ثلاثة مهاجمين، بينهم مقاتل مصري الجنسية، تسللوا عبر حواجز الأمن العام في المنطقة، واستهدفوا أحد مهاجع الحرس الروسي على أطراف المطار. ردت القوات الروسية على مصادر النيران، فقتلت إثنين من المهاجمين، بينما لا يزال مصير الثالث مجهولًا. وخوفًا من هجوم أوسع، استنفرت القوات الروسية قواتها، ووضعت مقاتلاتها الجوية في حالة تأهب قصوى، مع تشويش إلكتروني على الترددات اللاسلكية لقطع الاتصال بين المهاجمين ومنع استخدام طائرات مسيرة في هجوم محتمل.
مؤشرات مقلقة لنشاط تنظيم «الدولة»
على الصعيد الأمني، أعربت إدارة الأمن العام عن قلقها من نشاط محتمل لتنظيم «الدولة» في عدة مناطق، مركزة تحذيراتها على أقسامها في محافظة حلب، خاصة مدينتي الباب وأعزاز.
وأشار تحذير الأمن العام إلى أن خلايا التنظيم تعمل على «رصد مواقع عسكرية وأمنية تابعة للجيش السوري وإدارة الأمن العام، بهدف تنفيذ عمليات نوعية». ودعت الإدارة جميع العناصر العسكرية والأمنية، بما في ذلك الاحتياط، إلى «رفع الجاهزية الأمنية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتكثيف عمليات الرصد والتفتيش، خاصة في محيط المواقع العسكرية والمقرات». كما شددت على ضرورة مراقبة محلات بيع الأسلحة، ومنع تداولها بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المدنيين الذين يحملون أو يشهرون السلاح، وذلك حفاظًا على الأرواح والاستقرار.
في سياق متصل، شهدت مدينة حلب، الثلاثاء، أول اشتباك مباشر في قلب المدن السورية بين جهاز الأمن العام وخلايا تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية». جاء ذلك خلال حملة أمنية لملاحقة خلايا التنظيم، حيث داهمت قوة خاصة من جهاز الأمن العام، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، خليتين تابعتين للتنظيم في حيي الحيدرية والجزماتي بمدينة حلب.
وواجهت عملية الدهم مقاومة من عناصر الخلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عنصر من قوات الأمن العام وإصابة ثلاثة آخرين في حي الجزماتي، أحد الأحياء الشرقية للمدينة. وخلال العملية، فجر أحد عناصر التنظيم نفسه أثناء الاقتحام. وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال ثلاثة أشخاص سوريي الجنسية، لم يكن بينهم أي أجنبي، وتم تحديد هوياتهم، وهم: إبراهيم القاسم، الملقب «أبو إسراء»، من دير حافر بريف حلب الشرقي؛ ومحمد المصطفى، الملقب «أبو حميد»، من طعانة أخترين بريف حلب الشمالي؛ وأسامة الحمد، الملقب «أبو عبد الرحمن»، من دير الزور.
وواصلت دوريات الأمن ملاحقة عناصر مشتبه بهم، وفتشت منازل مجاورة وأخرى يُشتبه بأنها تأوي عناصر إضافيين من التنظيم.
في إدلب، يُعتبر جهاز الأمن العام الأكثر فعالية وسرعة استجابة مقارنة بالمناطق السورية الأخرى، بفضل بنيته التنظيمية القوية وعلاقاته المحلية المتينة. هذه العوامل ساهمت في تقليص الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك عمليات السطو والجريمة المنظمة، بشكل ملحوظ مقارنة بمدن مركزية مثل دمشق وحلب، أو مناطق الساحل ذات الغالبية العلوية.
في هذا السياق، يُفسر التحرك السريع للقوات الأمنية في إدلب بنجاحها في التصدي لعدة حوادث، أبرزها مقتل عنصر من وزارة الدفاع في كمين نصبه تنظيم «الدولة» بمنطقة مدايا بريف خان شيخون الشرقي، استهدف عنصرا في وزارة الدفاع. كما تعرضت وحدات من الجيش الجديد لكمين سابق في منطقة قريبة شمال خان شيخون، على الطريق بين بلدتي معرة حرمة والشيخ مصطفى، أسفر عن مقتل عنصرين عسكريين. هذه الحادثة دفعت جهاز الأمن العام إلى تكثيف جهوده لتعقب خلايا مشتبه بانتمائها إلى تنظيم «الدولة».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق من هذا العام، إحباط محاولة تفجير كبيرة قرب مقام السيدة زينب جنوبي دمشق. وتزامن ذلك مع مخاوف من هجوم واسع النطاق للتنظيم على دمشق خلال عيد الفطر، حيث حذرت بعثات دبلوماسية غربية رعاياها من هجمات محتملة تستهدف الأسواق، المطاعم، والمساجد خلال صلاة العيد.
شبكات موالية لإيران في مرمى الأمن العام
في سياق متصل، تواصل الخلايا الأمنية الموالية لإيران في شرق سوريا محاولات نقل السلاح باتجاه لبنان بدون توقف، وتسعى إدارة حرس الحدود لإحباط مختلف العمليات سواء تلك القادمة عبر الحدود أو المخزنة في مستودعات سرية في شرق سوريا ومناطق التهريب النشط في تل كلخ والقصير والقلمون وريف دمشق الغربي.
وأعلن جهاز الأمن العام في البوكمال عن ضبط شحنتي أسلحة، إحداهما قادمة من العراق إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والأخرى متجهة إلى الساحل السوري. وقال مدير أمن البوكمال إن قواته تعمل على «تأمين الحدود السورية-العراقية الطويلة والمعقدة»، مشيرًا إلى وجود قنوات تنسيق مع الجانب العراقي، لكنها «تعاني تأخيرًا بسبب الظروف السياسية».
وفي سياق جهود مكافحة التهريب، هاجم جهاز الأمن العام شبكة تهريب أسلحة ومخدرات يقودها حسين العلي الجغيفي، الملقب بـ«الحوت»، والمعروف بتبعيته لإيران في البوكمال. ونشرت إدارة الأمن العام تسجيلات مصورة تظهر اعتقال العلي وعددا من أبنائه وأفراد شبكته. وكشف مدير أمن البوكمال، مصطفى العلي، الأربعاء، عن العثور على 70 ألف حبة كبتاغون في منزل الجغيفي ببلدة الهري الحدودية، مؤكدًا استمرار عمليات البحث عن مستودعات أسلحة ومخدرات مخفية في المنطقة. كما نشرت الإدارة صورًا لصواريخ إيرانية مضادة للدروع، وصواريخ روسية المنشأ، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة.
وتُعدّ الحدود السورية-اللبنانية، خاصة في منطقة عكار اللبنانية وتلكلخ السورية، من أخطر مناطق التهريب وأصعبها بسبب التداخل الجغرافي. حيث يعيق نهر الكبير الجنوبي، الذي يفصل الحدود، جهود الضبط الأمني، بينما تزيد الجغرافيا الجبلية في القلمون الغربي من تعقيد العمليات، بسبب امتداد سلسلة جبال لبنان الشرقية على طول الحدود من القصير إلى جبل الشيخ، ما يجعلها ممرًا تاريخيًا للتهريب بين البلدين.
ووفقًا لإحصاءات جهاز الأمن العام، يتم إحباط عملية تهريب كل يومين تقريبًا، ما يشير إلى حجم العمليات الناجحة التي يتمكن المهربون من خلالها من نقل الأسلحة إلى لبنان أو تهريب حبوب الكبتاغون إلى الداخل السوري. وخلال الأيام الأخيرة، كشفت القوات الأمنية ووزارة الدفاع عن إحباط شحنة أسلحة مضادة للدبابات، وأكثر من 100 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» المتفجرة. وأظهرت صور متداولة مستودعًا لتجميع الأسلحة يحتوي على صواريخ إيرانية الصنع من طراز 107 ملم مع قاذفاتها.
وفي منتصف الشهر الجاري، اعترضت عناصر الأمن العام وفرقة حمص شحنة صواريخ أرض-أرض من نوع «غراد» المطورة (عيار 220 ملم)، وفقًا لتحليل الصور التي اطلعت عليها «القدس العربي». وفي القلمون الغربي، ضبطت القوات الحكومية السورية شحنة أسلحة وذخائر متجهة إلى لبنان عبر منطقة سرغايا، وأكدت مصادر في إدارة حرس الحدود اعتقال مهربين إثنين مع مصادرة شاحنتهم. وقبل هذه الحادثة، أحبط حرس الحدود عملية تهريب صواريخ «كورنيت» المضادة للدروع وقاذفة قنابل يدوية إيرانية الصنع.
تكشف الأحداث الأخيرة أن التحدي الأمني بات الهمّ الأبرز في سوريا بعد تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ويثير تنامي نشاط تنظيم «الدولة» قلقًا متزايدًا، حيث أظهر التنظيم قدرة على الانتقال من البادية السورية إلى الحواضر المدنية. وقد ساهم ضعف الأجهزة الأمنية في عدة مناطق، خاصة تلك التي كانت خارج سيطرة المعارضة قبل سقوط النظام، في تسهيل هذا التحول. ويبرز هذا الضعف بوضوح في الفجوات الأمنية التي سمحت للتنظيم بإعادة تنظيم خلاياه في المدن.
في الوقت ذاته، تظل مشكلة تهريب الأسلحة ونشاط الخلايا الموالية لإيران، مع احتمال اختراقها للأجهزة الأمنية السورية الجديدة، من أبرز العوائق التي تعرقل تحقيق الاستقرار. وتتركز هذه التحديات في المناطق الحدودية، سواء في غرب سوريا أو شرقها، حيث تستمر محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود مع لبنان والعراق، ما يهدد الأمن الإقليمي ويعقّد جهود إعادة بناء الدولة.
———————————
الشارع السوري يرحب بتخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على دمشق ويأمل في غد أفضل
رجل يطلق النار في الهواء من إحدى الشاحنات التي تقل بعضًا من 60 أسرة نازحة تعود إلى قريتها بعد أكثر من خمس سنوات بدعم من إحدى المنظمات غير الحكومية
25/05/2025
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا تخفيفا للعقوبات المفروضة منذ نصف قرن على بلد مزقته الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا.
رحّب السوريون في شوارع دمشق يوم السبت بالخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية التي بدأت قبل أكثر من 14 عاما.
وجاء احتفاء الشارع السوري بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي للعقوبات رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقبله الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عن نفس الخطوة الأسبوع الماضي خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
وقالت زينة شهلا، وهي إحدى السكان، لوسائل الإعلام المحلية: “بصراحة أنا بكيت عندما قرأت بالأمس خبر رفع عقوبات قيصر بالفعل، خاصة بعد التقارير التي سمعناها في الأسابيع الأخيرة”.
وأضافت: “إننا نرى أخيراً خطوات حقيقية نحو تعافي البلاد”.
ويأتي تخفيف العقوبات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الثلاثاء أنه تبنى نهجًا تدريجيًا وعكسيًا من أجل دعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد تعليق بعض العقوبات الاقتصادية في فبراير.
بالنسبة للولايات المتحدة، هدفت العقوبات التي فرضها الكونجرس، والمعروفة باسم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى عزل حكام سوريا السابقين من خلال حرمان من يتعامل معهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً مؤقتًا يوقف تطبيق هذه العقوبات بحق أي شخص يتعامل مع مجموعة محددة من الأفراد والكيانات السورية، ومن بينها البنك المركزي السوري.
وأدى الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية إلى تمديد تنازل مؤقت لمدة ستة أشهر عن بعض العقوبات الصارمة التي فرضها الكونغرس في عام 2019.
وتشمل هذه العقوبات تحديداً قيوداً على إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. وعلى الرغم من أنه يمكن تجديدها لمدة 180 يومًا بموجب أمر تنفيذي، فإن من المرجح أن يتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا من خوض مشاريع إعادة الإعمار في ظل إمكانية إعادة فرض العقوبات بعد انقضاء مهلة الستة أشهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهده برفع القيود المفروضة على البلد الذي تعاني من أزمة مستمرة منذ 14 عامًا.
وقالت وزارة الخارجية السورية يوم السبت إن سوريا “تمد يدها” لكل من يرغب في التعاون مع دمشق، شرط ألا يشمل هذا التعاون أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
أفادت إدارة ترامب يوم الجمعة بأن هذه الإجراءات “لا تزال مجرد جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتفكيك البنية الكاملة للعقوبات المفروضة”.
وكانت قد فُرضت تلك العقوبات على عائلة الأسد بسبب دعمها للميليشيات المدعومة من إيران، وبرنامجها الخاص بالأسلحة الكيميائية، وإساءة معاملة المدنيين.
وقال نائل قداح، المقيم في دمشق، إن البلاد ستشهد ازدهارًا جديدًا بعد تخفيف العقوبات.
ويرى قداح أن السوريين سيصبحون قادرين على تحويل الأموال بحرية، على عكس الماضي حين كانت عدة شركات تحتكر هذا المجال وتفرض عمولات مرتفعة على التحويلات.
وأضاف: “الآن يمكن لأي مواطن تلقي حوالة من أي مكان في العالم”.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن رفع العقوبات يهدف إلى تعزيز فرص بقاء الحكومة السورية المؤقتة، وهو قرار رحبت به القيادة الانتقالية في دمشق.
—————————-
ما دلالات زيارة الشرع المفاجئة إلى تركيا؟/ زيد اسليم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. 25/5/2025
أنقرة- في زيارة غير معلنة هي الثالثة له إلى تركيا منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى إسطنبول، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولما بهتشة.
وعُقد اللقاء خلف أبواب مغلقة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين من الجانبين، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، كما ضم من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصر.
سياق الزيارة
تأتي زيارة الرئيس السوري إلى تركيا في سياق إقليمي ودولي بالغ الأهمية، إذ تزامنت مع إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الغربية بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد يومين فقط من زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق، والتي تناولت ملفات أمنية حساسة، خاصة قضية تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية، وهو الملف الذي شهد تأخرا في التنفيذ عما كان معلنا سابقا.
وتأتي أيضا في ظل تصريحات أردوغان الأخيرة حول التواصل مع العراق وسوريا بشأن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مما يعكس مساعي تركيا لتحقيق تقدم في هذا الملف الأمني الحساس.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أهم الملفات
أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن اللقاء تناول جملة من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا ومسارات التعاون بين البلدين.
وأكد الرئيس أردوغان، خلال المباحثات، أن “أياما أكثر إشراقا وسلاما” تنتظر سوريا، مجددا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري كما فعلت منذ بداية الأزمة.
ورحب أردوغان بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر ذلك خطوة مهمة تهيئ الأرضية لعودة الاستقرار.
وفي ما يخص التصعيد الإسرائيلي، وصف الرئيس التركي الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدا استمرار تركيا في رفضها هذه الانتهاكات عبر كل المنابر الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في مجالات حيوية، على رأسها الطاقة والدفاع والنقل، إذ أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوفاء بما تقتضيه علاقات “الجوار والأخوة”، بما يشمل الدعم الفني والسياسي خلال مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.
وفي المقابل، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن امتنانه للموقف التركي، مثنيا على الدور الحاسم الذي لعبته أنقرة في رفع العقوبات ودفع المجتمع الدولي للاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق.
من جهتها، قالت الوكالة السورية للأنباء إن وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيان نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري ووزير خارجيته التقيا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، لبحث تطورات الملف السوري خلال الزيارة.
في السياق، يرى الباحث في مركز سيتا للدراسات كوتلوهان قورجو أن غياب أي إعلان رسمي أو تغطية إعلامية مسبقة لزيارة الرئيس السوري إلى تركيا لا يعني بالضرورة أنها كانت سرية، بل يعكس -برأيه- ضيق الحيز الزمني للزيارة، وطبيعة الملفات الحساسة المطروحة خلالها.
ويعتقد قورجو -في حديث للجزيرة نت- أن من بين العوامل التي دفعت لعقد هذا اللقاء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتعيين السفير الأميركي لدى أنقرة مبعوثا خاصًا إلى سوريا، إلى جانب تصاعد أهمية ملف وحدات حماية الشعب (قسد) في الأجندة الأمنية التركية.
ويلفت إلى أن مشاركة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في اللقاء تعزز الاعتقاد بأن قضية انتشار القوات الكردية وقضية “المواقع العسكرية المحتملة” كانتا ضمن أولويات جدول الأعمال، إلى جانب ما وصفه بـ”التقدم الفني في الحوار التركي الإسرائيلي بشأن سوريا”، الذي قد يكون طُرح أيضًا في اللقاء.
وأضاف قورجو أن لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص توم باراك يعكس حرص القيادة السورية الجديدة على التواصل المباشر مع واشنطن، وإدراكها حساسية هذا المسار، في ظل استمرار وجود ملفات عالقة بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الزيارات الميدانية التي أجراها مسؤولون سوريون إلى تلك المخيمات قد تكون جاءت استجابة ضمنية لبعض التوقعات الأميركية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أهمية الزيارة
يرى المحلل السياسي محمود علوش أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت على المشهد السوري مؤخرا، لا سيما في ما يتعلق بمسار التسويات السياسية والأمنية.
وحسب علوش، فإن أنقرة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمعالجة ملف قسد ضمن إطار اتفاقية الاندماج الجارية، التي تشكل جزءا من مسار أوسع متعلق بإحياء عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. ويعتقد أن الظروف أصبحت ناضجة لتحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الانسجام الأميركي النسبي” مع مقاربة تركيا للملف السوري.
كما يشير إلى أن أنقرة معنية أيضا بالتوصل إلى ترتيبات أمنية ثنائية مع دمشق ودول الإقليم لمواجهة تهديد عودة تنظيم الدولة (داعش)، بما يشمل ملف تسليم سجون داعش ومعسكرات الاحتجاز إلى الحكومة السورية، وهي خطوة ترى فيها تركيا ضرورة لتمكين دمشق من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة على حدودها.
ويختم علوش بالقول إن النتائج المباشرة لهذه الزيارة ربما لا تظهر فورا، لكنها -برأيه- ستتجلى تدريجيا من خلال استكمال مسار الاندماج وتنفيذ التفاهمات الأمنية والعسكرية التي جرى التوافق عليها بين الجانبين.
المصدر : الجزيرة
———————————–
العودة إلى سوريا ليست نهاية الطريق.. السكن والتعليم والصحة اختبار قاس للعائدين/ مختار الإبراهيم
2025.05.25
العودة إلى سوريا ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة محفوفة بالتحديات. بعد أكثر من أربعة عشر عامًا من الحرب، يعود أكثر من 1.5 مليون سوري إلى بلادهم ليكتشفوا واقعًا يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. في ظل غياب التنظيم القانوني لسوق الإيجارات، وارتفاع أسعار السكن، وتراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، يجد العائدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع هشاشة يومية تعمق الإحساس بالغربة داخل الوطن. وبين تفاوت في توفر الخدمات من مدينة لأخرى، واستمرار الانهيار الاقتصادي، يصبح قرار العودة بحد ذاته مغامرة شخصية لا تضمن الاستقرار، بل تطرح أسئلة جديدة عن القدرة على الاستمرار.
أعلنت الأمم المتحدة عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم منذ سقوط نظام الأسد، وقالت أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: “يحتاج 16.5 مليون شخص في سوريا للمساعدات الإنسانية والحماية”، مؤكدة استمرار العمليات الإنسانية رغم الصعوبات المتزايدة، وأضافت: ‘تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ما متوسطه 2.4 مليون شخص شهريًا من خلال عملياتها المحلية والعابرة للحدود.
وبعد أكثر من أربعة عشر عامًا من الحرب، لم تعد سوريا كما كانت. أدى النزاع إلى انهيار اقتصادي وخدمي واسع، مع نسب فقر تتجاوز 90% من السكان وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وبطالة متفشية، وتراجع في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة. رغم محاولات التعافي، فإن الواقع على الأرض لا يزال قاسيًا، وهو ما اكتشفه السوريون العائدون إلى بلادهم بعد سنوات في الخارج.
غلاء في الإيجارات وتراجع للخدمات
في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، عبّرت إسراء، إحدى السوريات العائدات من الخارج، عن تردي الواقع الخدمي والمعيشي، “أول مشكلة واجهتنا كانت الإيجارات، المبالغ المطلوبة كبيرة جدًا، ولا يوجد أي قانون ناظم لهذا الموضوع… صاحب المنزل يطلب السعر الذي يراه مناسبا دون ضوابط.”
كما أشارت إسراء إلى موضوع غلاء المواصلات داخل المدن، وارتفاع أسعار الفنادق، حتى أن قضاء يوم واحد في دمشق يشكل عبئًا ماليًا لشخص يحاول أن يسافر إلى دمشق للتقدم إلى وظيفة على سبيل المثال. أما الكهرباء، فشهدت تحسنًا طفيفًا في العاصمة، في حين لا تزال المدن الأخرى مثل مصياف -حيث تقيم إسراء- تعاني من انقطاعات طويلة، بوصل لا يتعدى نصف ساعة كل خمس إلى ست ساعات، يضاف إليها موضوع المياه أيضًا تصل مرة كل خمسة أيام ولساعات قليلة.
وتصف إسراء الشوارع “بالموحشة” نتيجة للظلام الدامس، ما جعل مدينة مصياف مثلا تبدو كمدينة أشباح، رغم وجود مبادرات محلية محدودة لتحسين الإنارة، لكنها تبقى غير كافية. وفيما يخص الغلاء، ترى إسراء أن أسعار السلع الغذائية انخفضت قليلاً، لكن هناك مصاريف كثيرة ترهق كاهل السوريين مثلا التعليم الحكومي لا يزال ضعيفًا، ويعتمد الطلاب على الدروس الخصوصية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية وهي مكلفة للغاية.
أين يسكن العائدون في دمشق؟
لكن مشكلة تأمين السكن تلقي بظلالها على من يفكر السكن في دمشق، وهنا يقول موسى بركات إنه بحث لأشهر عن منزل للإيجار، ووجد واحدًا فقط في ضواحي دمشق بأكثر من 200 دولار شهريًا، وذلك نتيجة لتدمير واسع في البنية السكنية في عموم سوريا، وغياب العرض الكافي للعائدين.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن حوالي 26.3% من الوحدات السكنية في سوريا تعرضت للدمار أو لأضرار جسيمة، وتم تدمير أكثر من 150 ألف وحدة في حلب وحدها. أما في دمشق، فقد فقدت المحافظة نحو 57 ألف وحدة سكنية، هذا النقص الحاد أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 300% في بعض المناطق.
من جهتها تؤكد بتول ما قاله موسى عن صعوبة الحصول على سكن للإيجار رغم الأرقام الفلكية مقارنة بالدخل، وتؤكد أن عودتهم من تركيا لم تكن إلى منزلهم الأصلي، فالقابون حيث كانوا يقطنون قبل الثورة وبلدة الصرخة في القلمون -بلدة أهل زوجها- دمرتا بالكامل، ما دفعها للاستقرار في حرستا، بالقرب من سكن أهلها، مع دفع إيجار شهري. وفي حديثها عن الوضوع الأمني تصف بتول الوضع الأمني بالمقبول، إلا أن “أخبار الحوادث الأمنية المتفرقة تنعكس سلبا على الجميع”.
التعليم والرعاية الصحية في سوريا
وعن التعليم، اضطرت بتول لتسجيل ابنها بمدرسة خاصة لرفض المدرسة الحكومية تسجيله لأن العام الدراسي اقترب على نهايته، وتصف مستوى التعليم الخاص بأنه “جيد وقريب من مستوى المدارس الحكومية في تركيا”.
كما تشير بتول إلى أن الرعاية الصحية مقبولة في مشفى حرستا، وخدمات المشفى الوطني جيدة. لكن الأدوية الأجنبية مرتفعة السعر وتدخل تهريبًا، كما لاحظت وجود فرق كبير بالخدمات بين حرستا ودمشق، حتى في جودة الهواء نتيجة للغبار والدمار.
أما بما يخص الاتصالات فقد تحسنت خدمة الإنترنت، فقد أصبح الإنترنت الفضائي متاحًا بعد أن كان محصورًا على الهاتف الأرضي، وكذلك المياه تحسّنت في منطقتها.
رغم التفاؤل الذي يحمله بعض العائدين، فإن الواقع السوري بعد أكثر من عقد من الحرب لا يزال يفرض تحديات ضخمة. من الإيجارات غير المنظمة، إلى الخدمات المتفاوتة، مرورًا بالدمار العمراني الذي حوّل العودة إلى اختبار قاسٍ للقدرة على التحمّل.
تعد شهادات بتول وإسراء وموسى جزءًا من مشهد أكبر، يُظهر الحاجة المُلحّة لإصلاحات واقعية، تبدأ بوضع حد لفوضى السكن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار للأسر التي اختارت العودة.
العودة إلى سوريا ليست قرارا سهلًا، ولكن من دون استجابة حقيقية من الجهات الرسمية، قد تصبح مجرّد رحلة جديدة في درب المعاناة.
ولعل التفاؤل بأن ينعكس رفع العقوبات الأميركية إيجابا على الاقتصاد والشروع بإعادة الإعمار هو ما يجمع كل من التقاهم موقع تلفزيون سوريا، فقد أعلن مؤخرا الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال فترات زمنية مختلفة.
تلفزيون سوريا
————————————-
مبعوث ترمب يشيد بخطوات الشرع في ملف المقاتلين الأجانب
السلطات السورية تتعهد مساعدة واشنطن على العثور على أميركيين مفقودين
الأحد 25 مايو 2025
أبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى سوريا توماس باراك إنه التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وأشاد “بالخطوات الجادة” التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.
وأضاف باراك، الذي يشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، في بيان أن اللقاء عقد في إسطنبول أمس السبت.
وجاء الاجتماع بعدما أصدرت إدارة ترمب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعلياً بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه “خطوة إيجابية”.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأحد أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأميركي باراك إن العقوبات لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على السوريين وتعوق جهود التعافي الاقتصادي.
وذكرت الوكالة أنهما ناقشا أيضاً سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، بخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
أزمة المفقودين
تعهدت السلطات السورية بمساعدة واشنطن في البحث عن أميركيين مفقودين في سوريا، وفق ما أفاد المبعوث الأميركي الى دمشق توم باراك اليوم، في إعلان يأتي بعيد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات.
وقال باراك في منشورات على منصة “إكس”، “خطوة قوية إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم” لإعادتهم إلى بلدهم. ومن أبرز المفقودين أوستن تايس، الصحافي المستقل الذي خطف في سوريا عام 2012.
وأنقرة من الداعمين البارزين للحكومة السورية الجديدة، وتدعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وشارك أردوغان عبر الإنترنت في اجتماع في الرياض بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والشرع في منتصف مايو (أيار) الجاري.
وكان الشرع زار تركيا للمرة الثانية في أبريل (نيسان) الماضي للمشاركة في منتدى دبلوماسي.
وأعرب أردوغان والشرع عن عزمهما على مكافحة “التهديدات الإرهابية” في سوريا بصورة مشتركة. وتطالب أنقرة بطرد المقاتلين الأكراد الأجانب من شمال شرقي سوريا وتقول إنها تريد مساعدة جارتها في محاربة تنظيم “داعش”.
———————————
السلطات السورية ستساعد واشنطن في العثور على أميركيين مفقودين
دمشق: «الشرق الأوسط»
25 مايو 2025
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الأحد، أن الحكومة السورية وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد مكان مواطنين أميركيين وإعادتهم أو رفاتهم، واصفاً ذلك التحرك بأنه «خطوة قوية إلى الأمام… يحق لعائلات أوستن تايس، ومجد كمالماز، وكايلا مولر أن يعرفوا مصير أحبائهم».
وتابع باراك في حسابه على منصة «إكس»، أن ترمب أكد أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم، أو تكريم رفاتهم بكرامة، أولوية قصوى في كل مكان: «وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام».
وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس، وماجد كمالماز وكايلا مولر. وخطف تايس، في 14 أغسطس (آب) 2012، قرب دمشق، وكان عمره 31 عاماً ويعمل صحافياً مستقلاً مع مجموعة ماكلاتشي و«واشنطن بوست» و«وكالة الصحافة الفرنسية» ووسائل إعلام أخرى. ولم تتوفر معلومات عن مصيره. وقد زارت والدته دمشق والتقت الرئيس الشرع بعد إطاحة حكم الأسد.
وخطف تنظيم «داعش» عاملة الإغاثة (مولر) في حلب (شمال)، أغسطس (آب) 2013. وأعلن، في فبراير (شباط)، مقتلها في غارة جوية شنتها طائرات أردنية على مدينة الرقة، التي شكلت حينها المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا. وأكدت واشنطن لاحقا مقتلها، لكنها شككت في صحة رواية التنظيم المتطرف.
وفُقد المعالج النفسي مجد كمالماز، وهو أميركي ولد في سوريا، بينما كان في زيارة خاصة إلى دمشق، بعد توقيفه على نقطة أمنية عام 2017. وكان متخصصاً في العلاج النفسي للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، وعمل مع اللاجئين السوريين في لبنان بعد اندلاع النزاع. وأفادت تقارير غير مؤكدة لاحقاً عن وفاته في السجن.
وبحسب مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأميركية بشأن ملف المفقودين، فإن هناك 11 اسماً آخر على قائمة واشنطن، وهم سوريون لديهم جنسيات أميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وجاء إعلان الدبلوماسي الأميركي بعدما كانت واشنطن سعت مراراً، خلال حكم الأسد، للحصول على معلومات حول رعاياها المفقودين في سوريا. وكان باراك قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول، أمس، وأشاد بـ«الخطوات الجادة» التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.
جاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترمب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعلياً، بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه «خطوة إيجابية». وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات؛ إذ قال الشرع للمبعوث الأميركي إن العقوبات لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.
وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضاً سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
ومنحت إدارة ترمب سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات الجمعة، في خطوة أولى رئيسية نحو الوفاء بتعهد الرئيس برفع عقوبات دامت نصف قرن على بلد دمرته 14 عاماً من الحرب الأهلية.
وألغى إجراء من وزارة الخارجية لمدة 6 أشهر مجموعة صارمة من العقوبات التي فرضها الكونغرس في عام 2019. واتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراء يعلق تطبيق عقوبات ضد أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
وقال ترمب خلال زيارة للمنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة ستتراجع عن العقوبات المالية المشددة في محاولة لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أفضل للبقاء.
——————————–
سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية لاستعادة موقعنا الطبيعي
الآثار المباشرة قد تكون محدودة راهناً ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار
دمشق: سعاد جروس
24 مايو 2025 م
رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات.
وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم».
أيام ذهبية آتية
كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا.
ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني».
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة.
وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا».
دلالات سياسية
رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية.
وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة».
وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً.
إجراءات كبيرة وسريعة
ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين.
كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.
————————————–
==========================