خطاب الكراهية.. الدوافع والمآلات/ فيصل علوش
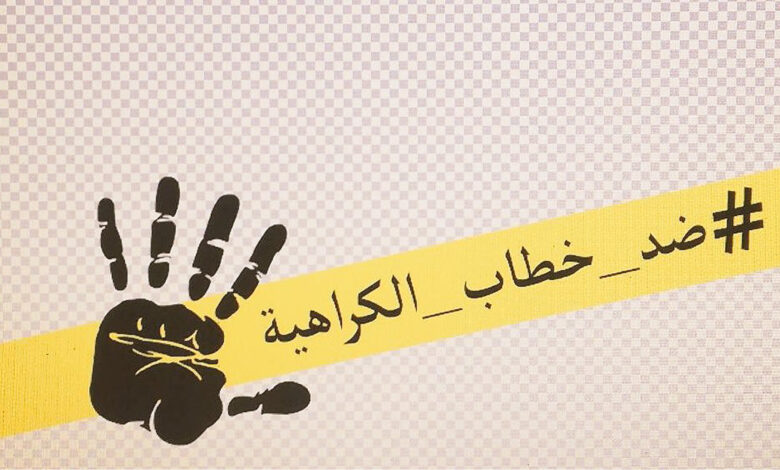
4 مايو 2025
تتفق المراجع التي تناولت خطاب الكراهية على تعريفه بأنه؛ أيّ شكل من أشكال التعبير التي تشجّع على التمييز وتحض على الكراهية، بهدف تشويه سمعة فرد أو جماعة، (مجموعة من الأفراد)، أو مضايقتهم وإذلالهم، أو إيذائهم وترهيبهم، وصولًا إلى تجريدهم من إنسانيتهم، كتمهيد لاستخدام العنف ضدهم، وذلك على خلفية هوياتية تتصل بانتمائهم العرقي أو الديني أو الإثني أو الطائفي أو الجندري.. إلخ.
ولدى البحث في طبيعة وأبعاد وتأثيرات هذا الخطاب، يمكننا التوقف عند النقاط التالية:
– يتصف هذا الخطاب بالتعميم والتنميط السلبي، وإلقاء اللوم على جماعة بأكملها وتحميلها مسؤولية واقعة ما، أو أفعال فردية، فعلية كانت أو مفترضة ومتخيلة، مخالفًا المبدأ القانوني والأخلاقي الذي يقول بالمسؤولية الفردية. على غرار ما حصل أخيرًا، حين قام شخص محدد بالإساءة إلى النبي محمد (ص)، فتوجهت ردود الفعل الغريزية العمياء نحو أماكن معروفة يقطنها سكان من الجماعة التي ينتمي إليها ذلك الشخص، فقامت بإطلاق الرصاص وإلقاء القذائف العشوائية عليها، موقعةً عددًا من القتلى والجرحى، وتوجهت كذلك نحو طلاب أبرياء يتبعون إلى تلك الجماعة، لتصبّ جام غضبها عليهم، ملحقة الإيذاء النفسي والجسدي بهم.
– خطاب الكراهية، (أو الأفعال المستندة إليه)، لا يفصل بين الكراهية التي يفترض أن تطال فعلًا محددًا سياسيًا أو أخلاقيًا، كالظلم مثلًا، وبين الجماعة التي قد يلحق بها صفة ارتكاب هذا الفعل. فالسيد المسيح يقول، مثلًا: “أنا أكره الظلم لا الرومان”، وهو المثل الذي يشكل نموذجًا للتمييز والفصل بين كراهية الفعل المذموم، وبين الكراهية التي قد تطال جماعة أو شعبًا بأكمله (كأن نقول: أنا أكره الرومان). فخطاب الكراهية يقوم على شيطنة الجماعة ككل، وطلب العقاب الجماعي لها، دونما تمييز بين شخص ملام وآخر بريء. في حين أن القانون والأخلاق يقولان بالمسؤولية الفردية والعقاب الفردي. ولقد تكررت عبارة “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”، في غير موضع من القرآن الكريم، كتأكيد على المسؤولية الفردية، وعلى أنّ الله تعالى لا يظلم نفسًا، عبر تحميلها وزر ما لم ترتكب من إثم.
– خطاب الكراهية لا يقتصر علينا نحن في سوريا، بل ثمة موجة عاتية من الكراهية والعنصرية والتعصب تعصف بالعالم ككل؛ سواءً في بلدانه الديمقراطية أم الدكتاتورية، مهددة الأمن والاستقرار في غير مكان من العالم. ويتمثل ذلك في الخطاب الشعبوي المعادي للمهاجرين والمسلمين والسود، مثلًا، وفي التيارات والحركات الشعبوية النامية والمنتشرة في الغرب، وفي ظواهر النازيين الجدد، وتيارات تفوق الإنسان الأبيض، (كما في الظاهرة الترامبية)، المتعارضة مع قيم التسامح والعيش المشترك.
– ظاهرة الكراهية هذه، المنتشرة على نطاق واسع في العالم، تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي التي تزيد في تأجيج الكراهية، على الرغم من أن مسلسل التكاره والتباغض قديم، وقصة استخدام الاختلاف والتباين الإثني أو القومي أو الديني أو المذهبي، لزرع العداء والاحتراب بين البشر، قديمة وسبقت الإنترنت بزمن طويل. بيد أن الآليات التواصلية والتفاعلية الخاصة والجاذبة التي تتيحها وسائل التواصل، (ومنها ظاهرة الحسابات المزورة والذباب الالكتروني)، تساهم أكثر في انتشار خطاب الكراهية، وخصوصًا في ظل الاستقطابات الحادة القائمة على مستوى العالم عمومًا، وداخل كلّ بلد على حدة. وهنا رب قائل يقول، ولكن وسائل التواصل متاحة للجميع، فلماذا تساهم في انتشار خطاب الكراهية دون سواه من خطابات متنورة؟ وعلى رغم مشروعية ووجاهة التساؤل هذا، إلا أنه علينا الإقرار، في الواقع، بأن الخطاب العقلاني والمنطقي غالبًا ما يخسر المعركة في مواجهة خطاب التعبئة والتجييش القومي والطائفي، مثلًا، لأنه يخفق في إقناعنا بأن “الآخر لا يختلف عنا، وبأنه من غير الصحيح أننا نحن، نحن فقط، أكثر الناس أصالة ودينًا وحكمة وأخلاقًا.. إلخ”!
– يرتبط مفهوم خطاب الكراهية بقضية الحق في التفكير وحرية التعبير والفكر والمعتقد. ولذلك ففي الدول الغربية، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، يتحفظون على تجريم خطاب الكراهية بحد ذاته، ويعدون ذلك مسًّا بحرية الرأي والتعبير، مكتفين بتجريم التحريض على الكراهية، الذي يشكل عتبة للانتقال من الفعل الكلامي إلى الفعل المادي المباشر، (العنف والقتل وارتكاب المجازر)، لأنه يستهدف صراحة وعمدًا تكريس التمييز والعداء والحض على العنف.
ويميلون في الغرب إلى استخدام مصطلحات بديلة من قبيل؛ “التعصب، التنميط السلبي، الوصم، التمييز والتحيز”. وهنا علينا أن ننتبه لضرورة التمييز بين هذين الأمرين؛ وعدم تحويل التصدي لخطاب الكراهية إلى حجة وذريعة، من قبل السلطات، لقمع حرية الفكر والتعبير والتضييق على الحريات العامة وتقييدها. فهذه الحريات هي الكفيلة، في نهاية المطاف، ومن خلال “سوق الأفكار المفتوح”، في عملية الكشف عن الحقيقة، ومنع تطور العقائد المضمرة والباطنية، أو التعصب لحقائق زائفة.
– قد يكون الدافع وراء خطاب الكراهية قوميًا أو دينيًا أو مذهبيًا أو جندريًا، ولكنه لا يتكرس، في المحصلة، إلا عبر ممارسات وسلوكيات تفضي إلى تقسيم المجتمع إلى “نحن” و”هم”. وهو ما يؤدي، بدوره، إلى تفعيل ديناميات وآليات خاصة؛ شعورية أو عقلانية، تعمّق من الانقسام الحاصل، وتزيد في الاستقطاب والكراهية والتباغض، وتاليًا، الصراع واللجوء إلى العنف وأعمال القتل، وهو ما تكفل به النظام البائد، على مدى أكثر من خمسة عقود.
وعلى الحكم الجديد، في هذه الحالة، أن يحاذر كل الحذر من أن يأتي ردّه على نحو شبيه بما كان يقوم به سلفه، أو من جنس أفعاله وممارساته ذاتها. الانزلاق إلى فعل هذا، وعدا عن أنه يفقد السلطة الجديدة إمكانية تقديم نفسها كبديل سياسي وأخلاقي عن النظام الساقط، فإنه يكون، عادةً، أشبه بشرك تقع فيه السلطة الجديدة، بما يُفسح المجال للمقارنات السلبية بين أفعال السلطتين، هذا فضلًا عن كونه وصفة أكيدة للفشل واستمرار المقتلة السورية إلى أجل مفتوح.
فخطاب الكراهية والتحريض الطائفي قد يشدّ عصب جماعة ما، ولكن ذلك لا يحصل، غالبًا، إلا لدى جماعات هشة تفتقر إلى الوحدة والتماسك الداخلي، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بهذا الخطاب، على هذه الضفة أو تلك. وعندما يبدأ هذا الخطاب بالتفشي، ويبدأ معه تراكم الغبن والمظلومية، فمؤكدٌ أن ذلك سيهدد مقومات العيش المشترك، وسيشكل خطرًا على ثقافة التنوع وخطاب التآخي والتسامح، وفي النهاية، تكريس ثقافة الإقصاء وتجذير الكراهية، وتعزيز اللجوء إلى العنف، واستدعاء الخارج للتدخل أيضًا. فالطريق إلى الاقتتال والاحتراب الداخلي وارتكاب الانتهاكات والمجازر، وصولًا إلى الإبادة الجماعية، في أي مكان من العالم، غالبًا ما يكون مرصوفًا بخطاب الكراهية والتحريض عليه، مع وجود أطراف خارجية متربصة وداعمة ومستفيدة، وجاهزة للتدخل لتحقيق غاياتها الدنيئة.
أما الطريق إلى الحلول الممكنة وتجاوز ذلك في سوريا، فهو معروف أيضًا، وأدواته ووسائله الداخلية تكمن في اللجوء إلى فتح مسار “العدالة الانتقالية” والمضي فيه مهما كانت التعقيدات المحيطة به. وتعزيز دور الدولة الوطنية المحايدة تجاه مجتمعها ومكوناته، دولة القانون والمؤسسات الكفيلة بحماية مواطنيها كافة دون تمييز، واللجوء إلى الحوار وتطوير العقلية التفاوضية بدل عقلية الإلغاء والإقصاء. فأساس العنف غالباً ما ينطلق من الجهل بالآخر، ويستند إلى سرديات باطلة ومضللة عنه، وبالتالي فإن معرفته يمكن أن تقلل من التوتر وتساعد على تقبل الآخر على المستوى النفسي والاجتماعي، وتنمي ثقافة التفاهم وصولًا إلى بناء حصانة مجتمعية ضد الكراهية وخطابها.
الترا سوريا




