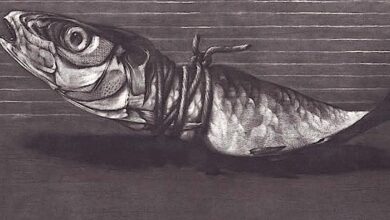العدالة الانتقالية تحديث 10 أيار 2025

لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
—————————-
أهمية إطلاق هيئة العدالة الانتقالية في سورية اليوم/ رضوان زيادة
09 مايو 2025
بسبب العدد الكبير لجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبها النظام البائد بحقّ السوريين على مدى الـ14 سنة الماضية، لا بدّ من تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية من أجل تحقيق أهداف مباشرة، وضمان تحقيق السلم على المستوى البعيد عبر تحقيق المحاسبة والعدالة للضحايا بما يمنع من عمليات الانتقام التي بدأت تتصاعد كثيراً في حمص وحلب والساحل السوري، وإعادة النقاش السياسي إلى التركيز على جرائم الأسد الفظيعة بحقّ السوريين، ولا سيّما أن النقاش انحرف كثيراً بالتركيز في ما يجري في الساحل فقط. ويتحقق ذلك عبر ما تسمّى جلسات الاستماع العمومية التي تركز على جرائم الأسد، وإنصاف الضحايا عبر إطلاق مسار رسمي يشمل الكشف عن مصير المختفين قسرياً عبر البحث عن مصيرهم، وضمان تحقيق العدالة لهم عبر التعاون مع وزارة العدل لتأسيس ما تسمّى المحكمة السورية الخاصّة بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وتأسيس معادل وطني للمؤسّسات الدولية التي تشكّلت بعد بداية الثورة، مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة والآلية الدولية المحايدة الخاصّة بالمساءلة الجنائية والمؤسّسة المستقلّة المعنية بالمفقودين، وكلتا الآليتين شكّلتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة. ولذلك يجب أن تتشكّل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية نظيراً وطنياً يستطيع التعامل مع هذه الآليات، وتحقيق العدالة بالنسبة إلى كثير من أسر الضحايا في ما يتعلّق بتقدير التعويضات الضرورية الخاصّة لهم، وضمان مسؤولية نظام الأسد عن ارتكاب هذه الجرائم، وتحقيق المصالحة الوطنية هدفاً بعيداً عبر تجنّب مبدأ الإدانة العامّة لطائفة بعينها، وإنما تقديم المسؤولين الفرادى المسؤولين عن ارتكاب الجرائم للعدالة، وهو ما يفتح الباب لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان السلم الأهلي.
أشار الرئيس أحمد الشرع، في أكثر من خطاب له، وبخاصّة الخطاب الموجّه إلى مؤتمر الحوار الوطني، إلى تأسيس هذه الهيئة، كذلك نصّ البيان الختامي للمؤتمر المذكور على تأسيس هذه الهيئة، ونصّ الإعلان الدستوري على تأسيس الهيئة السورية للعدالة الانتقالية في مادته الـ”49″، على أن “تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء”.
ولذلك، لا بدّ من التزام تأسيس هذه الهيئة كما وعد الرئيس في أكثر من خطاب له.
وفي معنى العدالة الانتقالية، نقول إن مجتمعاتٍ كثيرة مرّت بما مرّت به سورية، ولا سيّما في أفريقيا وأميركا اللاتينية، لكنّها استطاعت فيما بعد أن تخرج من تلك الفترة السوداء في تاريخها عبر فتح صفحة جديدة قائمة على الحقيقة والمحاسبة والعدالة، ومن ثمّ المصالحة، وهو ما يطلق عليه “العدالة الانتقالية”. وتشير العدالة الانتقالية إلى حقلٍ من النشاط أو التحقيق يركّز في المجتمعات التي تمتلك إرثاً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو أشكال أُخرى من الانتهاكات تشمل جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، من أجل بناء مجتمع أكثر استقراراً لمستقبل آمن. يمكن إدراك المفهوم من خلال عدة مصطلحات تدخل ضمنه مثل إعادة البناء الاجتماعي، والمصالحة الوطنية، وتأسيس لجان الحقيقة، والتعويض للضحايا، وإصلاح مؤسّسات الدولة العامّة، التي غالباً ما ترتبط بها الشبهات في أثناء النزاعات الداخلية المسلّحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.
وهو ما حصل في تشيلي (1990) وغواتيمالا (1994) وجنوب أفريقيا (1994) وبولندا (1997) وسيراليون (1999) وتيمور الشرقية (2001) والمغرب (2004) وتونس (2011)، فمع حدوث التحوّل السياسي، بعد فترة من العنف أو القمع في أي مجتمع، يجد المجتمع نفسه، في أحيانٍ كثيرة، أمام تركة صعبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك تسعى الدولة للتعامل مع جرائم الماضي، رغبةً منها في تعزيز العدالة والسلام والمصالحة. وستتركّز أهداف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة في عدد من البرامج الرئيسة:
أولاً: لجان الحقيقة وجلسات الاستماع العمومية: ستجمع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة البيانات والمعلومات الخاصّة بالضحايا، وتُشكَّل لجان خاصّة بالتحقيق في كلّ من عمليات القتل وتوثيق حالات التعذيب والاعتقال السياسي والاختفاء القسري. وستقوم هذه اللجان بتحقيقات رسمية في أنماط الانتهاكات التي وقعت لوضع سجلّ تاريخي دقيق لما وقع من الأحداث. إن إنشاء هذه اللجان المختلفة الخاصّة بالانتهاكات من شأنه أن يعمل على إنشاء أجهزة تحقيق قوية لكشف الحقائق المتعلّقة بالعنف الذي ارتكبته جهات تابعة لنظام الأسد أو جهات غير تابعة لها، بشكل غير مباشر مثل مليشيا الدفاع الوطني أو حزب الله أو المليشيات الإيرانية، التي كثيراً ما تتعرّض للإنكار أو الإخفاء.
من المفروض لهذه اللجان المشكلة أن تعمل على إثبات الحقيقة بشأن ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحقّ السوريين على يد نظام الأسد، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عبر تقديم ملفاتٍ للمحاكم والهيئات القضائية عبر تشكيل المحكمة السورية الخاصّة بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وأن توفّر منبراً عاماً للضحايا، كذلك تحفّز على النقاش العام وإثرائه بشأن قضايا العدالة الانتقالية والمصالحة، وتوصي بتعويضات للضحايا عبر إيجاد حوار مباشر معهم، وتوصي بالإصلاحات القانونية والمؤسّسية اللازمة، وتعزّز المصالحة الوطنية لأنها تعمل على مستويات مختلفة أهمها المستويَين الشعبي والمحلّي، مع تنظيم عدد من جلسات “الاستماع العامّة” التي يشارك فيها الضحايا بشكل رئيس، ويتحدّثون عن معاناتهم، وهو ما من شأنه أن يكسر الحاجز الطائفي عندما تظهر الضحايا بوصفها تنتمي إلى طوائف مختلفة، ما يلعب دوراً مهمّاً في ما يسمى الشفاء الاجتماعي، بعد الحالة المرضيّة التي عاشها المجتمع السوري من استخدام العنف المكثّف أكثر من 14 عاماً.
ثانياً: رفع الدعاوى القضائية والمحاسبة: تعتبر إقامة العدالة الجنائية عنصراً أساسياً من عناصر التصدّي المتكامل للانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في سورية، لذا لا بدّ أن ينصبّ رفع الدعوى على المتهمين من الأفراد، وينبغي أن تهدف برامج إقامة الدعوى أيضاً على استعادة كرامة الضحايا واسترداد ثقة الشعب السوري في سيادة القانون.
تشمل المحاكمات القيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية ضدّ مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سورية خلال فترة الثورة، ويمكن لهذه المحاكمات استهداف المرتكبين لهذه الجرائم أو التركيز على العاملين في المستويات القيادية العليا فقط في هيكلية نظام الأسد، المسؤولين عن إصدار أوامر بتلك الانتهاكات والجرائم، أو الذين لديهم صلاحيات إدارة نافذة على مرتكبي تلك الجرائم، ولا يُستثنى من ذلك من ارتكب الانتهاكات ضدّ المدنيين ، ويتعيّن إجراء هذه المحاكمات بما يتّفق مع معايير المحاكمات العادلة في إجراءاتها، وذلك لتجنّب أي طعون في مشروعيتها.
ثالثاً: التعويضات: أمام الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، أصبح لزاماً على الحكومات السورية اللاحقة، ليس التصدّي لمرتكبي هذه التجاوزات فقط، بل ضمان حقوق الضحايا كذلك. وبوسع الحكومة السورية الانتقالية أن تهيّئ الظروف الملائمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيق العدل بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة. وينطوي مفهوم التعويض على عدّة معانٍ، من بينها التعويض المباشر (عن الضرر أو ضياع الفرص)، ورد الاعتبار (لمساندة الضحايا معنوياً وفي حياتهم اليومية) والاسترجاع (استعادة ما فقد قدر المستطاع)، ويمكن التمييز بين التعويضات بحسب النوع (مادّية ومعنوية) والفئة المستهدفة (فردية/ جماعية). ويمكن أن يحصل التعويض المادي من طريق منح أموال أو حوافز مادّية، كذلك يمكن أن يشمل تقديم خدمات مجّانية أو تفضيلية، كالصّحة والتعليم والإسكان. أمّا التعويض المعنوي، فيكون مثلاً عبر إصدار اعتذار رسمي، أو تكريس مكان عام (مثل متحف أو حديقة أو نصب تذكاري) أو إعلان يوم وطني للذكرى.
أما الأهداف المتوخّاة من تدابير التعويض (مادّيةً كانت أو معنويةً)، فهي عديدة ومتنوعة، ومنها الإقرار بفضل الضحايا جماعات وأفراداً، وترسيخ ذكرى الانتهاكات في الذاكرة الجماعية، وتشجيع التضامن الاجتماعي مع الضحايا، وإعطاء ردّ ملموس على مطالب رفع الظلم وتهيئة المناخ الملائم للمصالحة عبر استرجاع ثقة الضحايا في الدولة، إضافة إلى أن مبدأ التعويضات أصبح إلزامياً بموجب القانون الدولي.
ولذلك، ستلعب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة دوراً رئيساً في تحديد وتقدير حجم وشكل ونوع طريقة التعويضات المناسبة والضرورية للضحايا من كلّ الأطراف من خلال عدة لجان يجب أن تشكّلها الهيئة لهذا الموضوع، منها لجنة التعويض وصيغ جبر الضرر المادّية.
رابعاً: إصلاح المؤسّسات: تحتاج سورية الخارجة حديثاً من الديكتاتورية إلى تبنّي إصلاحات تشمل مؤسّساتها وقوانينها وسياستها، بهدف تمكين البلاد من تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية البعيدة المدى، التي تعتبر ضروريةً لتفادي وقوع انهيار حضاري و/أو ديمقراطي في المستقبل. الإصلاحات المؤسّساتية بشكل عام يكون الهدف منها إزالة الشروط التي أدّت إلى نشوء فترة النزاع أو القمع. ولذلك ستسعى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة لضمان إصلاح المؤسّسات بما يهدف إلى إعادة هيكلة مؤسّسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان،
وإزالة التمييز الحزبي أو الطائفي الذي يشعر بعضهم أنه مورس ضدّهم من حزب البعث في مؤسّسات الدولة، وبخاصّة الجيش والأجهزة الأمنية، ومنع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسّسات الحكومية.
خامساً: إحياء الذكرى من طريق أيّ حدث أو واقعة أو بناء يستخدم بمثابة آلية للتذكّر. ويمكن إحياء الذكرى رسمياً، مثل إقامة نصب تذكاري، أو غير رسمي مثل بناء جدارية في مجتمع محلّي، سواء كان ذلك من الدولة، أو تلقائياً من المواطنين. ويسعى الناس لإحياء ذكرى أحداث الماضي لأسباب عديدة، منها الرغبة في استحضار ذكرى الضحايا والتعرّف إليهم، وتعريف الناس بماضيهم، وزيادة وعي المجتمع، ودعم رواية تاريخية أو تعديلها، وتشجيع تبنّي الاحتفال بالذكرى وتبنّي عملية العدالة الانتقالية من مستوى محلّي.
إن بناء نُصب تذكاري عملية تنطوي في طيّاتها على عناصر السياسة والتاريخ والجمالية. وتعتبر النُّصب التذكارية، من حيث إنها ممارسات في عملية بناء الأمّة، جزءاً من بيئة مادّية واجتماعية يمكن أن تساعد في تحديد وبناء مفهوم مشترك للتجربة الجماعية والخيال والنظرة الذاتية لشعب من الشعوب. وتتفاعل جميع النُّصب التذكارية مع الأشخاص الذين يشتركون في إقامتها، وليس لها أيّ سلطة ذاتية، وإنما تنشّط من الناس، وهي تتوقّف في تأثيرها النهائي لإحياء الذكرى على الناس الذين يأتون لزيارتها.
لا مخرج لسورية من استحكام خروجها من الشرخ الاجتماعي العميق الذي سيعقب إنهاء الصراع المسلّح، إلا بقرار تاريخي من نمط “المصالحة الوطنية”، والمصالحة هنا تأتي تتويجاً لكلّ مراحل العدالة الانتقالية التي أشير إليها آنفاً، وعندها يستطيع المجتمع السوري أن يخرج من انقساماته الاجتماعية والطائفية العميقة باتجاه الشراكة في بناء المستقبل.
العربي الجديد
——————————
سوريّون في فخ الكراهية/ مالك الحافظ
2025.05.09
ربما يعرف كثير من السوريين قصة رواندا، ذلك البلد الذي شهد في عام 1994 واحدة من أفظع الإبادات الجماعية في العصر الحديث، حين قُتل نحو 800 ألف شخص في مئة يوم فقط، على خلفية تحريض متواصل بثّته إذاعة “راديو ميل كولين”.
الكلمات هناك لم تكن بريئة، “اقطعوا الأشجار الطويلة!” كانت هذه العبارة الأخطر، الشيفرة المباشرة للدعوة إلى قتل التوتسي، حيث تحوّلت اللغة إلى أداة قتل منهجي، مُجرِّدة الضحايا من إنسانيتهم وممهّدة الطريق لجرائم إبادة لا توصف.
هذه التجربة هي مرآة مخيفة تعكس كيف يمكن لخطاب الكراهية، إذا تُرك دون مواجهة، أن يشق طريقه من الشاشات إلى النفوس، فيحوّل الخلافات العادية إلى صراعات مدمّرة تمزق النسيج الاجتماعي قطعةً قطعة.
لعل ما يعمّق خطورة مشهدنا السوري اليوم هو أن المحرّضين لدينا يظهرون على هيئة صفحات وأسماء يدّعي أصحابها أنهم “مؤثرون” على وسائل التواصل الاجتماعي.
أغلبهم ليسوا إعلاميين محترفين ولا مفكرين، بل سطحيون فارغون فكرياً يمارسون التحريض بدم بارد، فيجعلون من صفحاتهم مزارع تعبئة غوغائية، ويدفعون جمهورهم إلى لعب أدوار الذباب الإلكتروني الذي يهدد النسيج السوري المتشظي أصلاً بمزيد من الانهيار.
إن جوهر الانحدار في خطاب الكراهية يتمثل في مفعوله التراكمي بنزع الصفة الإنسانية عن الضحية، فحين يُسمّى البشر “صراصير” كما حصل مع التوتسي مثلاً، فإن المسألة قد تحوّلت إلى صناعة سرديات شيطنة تُحوّل الآخر إلى شيء، إلى مادة، إلى عدو خارجي يُلقى خارج حدود الإنسانية.
ما نراه اليوم من انحدار خطير في الخطاب الرقمي السوري لا يُعبّر عن قوة موقف أو شجاعة تعبيرية، إنما في جوهره، تعبير فجّ عن الضعف الأخلاقي والعجز الفكري. هؤلاء المؤثرين لا يتقنون سوى تكرار سرديات التخوين وتضخيم العصبيات المناطقية والطائفية، ويقودون من حيث لا يعلمون حملات ممنهجة لتدمير أي بذرة حوار وطني حقيقي. الأكثر مدعاة للقلق أن هؤلاء يتخفّون وراء شعارات الوطنية، في حين أن ممارساتهم قد لا تختلف كثيراً عن أدوات الحرب النفسية التي تخدم مصالح التقسيم والانقسام.
لا يمكن النظر إلى هذه الظاهرة كحالة سورية خاصة فقط، بل بوصفها جزءاً من نمط عالمي يتكرر في أزمنة الأزمات الكبرى، كما يوضح مانويل كاستلز، الفيلسوف وعالم الاجتماع الإسباني، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتج أيضاً شبكات تعبئة للغضب الجماعي، تتحول عبرها المشاعر الفردية إلى حركات جماهيرية رقمية قابلة للتوسع والتطرف. يرى كاستلز أن الطبيعة اللامركزية لهذه الشبكات تجعلها بيئة مثالية لتكريس الانقسام، لأنها تُضخّم الصدمات العاطفية وتُعيد إنتاجها بلا توقف.
إن من أخطر معوّقات مواجهة خطاب الكراهية في سوريا هو ما يمكن تسميته بثقافة تقديس الأشخاص، فحين يتحول الأفراد إلى تماثيل رمزية شبه مقدسة، يصبح المساس بهم، حتى نقداً بسيطاً أو تلميحاً عابراً، بمثابة ارتكاب “فجور فكري” أو “خيانة جماعية”.
هذه الظاهرة هي جزء من بنية عصبوية عميقة وصفها ابن خلدون قبل قرون بأنها “الروح الجامعة للجماعة”، لكنها في حالتنا المعاصرة تحولت إلى أداة تدمير داخلي. يقول ابن خلدون إن العصبية ضرورية لتماسك الدولة، لكنها إذا تجاوزت حدودها المعقولة تحولت إلى سبب سقوطها، لأن “التغلب والاستبداد مؤذن بالفساد”، أي أن العصبويات حين تعمى تفقد غايتها الأصلية في الحماية، وتتحول إلى دائرة مغلقة من الكراهية والصدام.
حين نقدّس الأشخاص، فنحن نتحوّل عملياً إلى وكلاء كراهية ضد كل من لا يشاطرنا عبادة تلك الأصنام البشرية. نغفر الأخطاء، ونتجاهل الكوارث، ونشيطن المختلفين، لأن نقد “الزعيم” أو “الشخصية الرمزية” يُفسَّر تلقائياً كاعتداء على الجماعة كلها. هذه آلية ذهنية خطيرة، لأنها تصنع مجتمعات عاجزة عن المراجعة الذاتية وتحوّلها إلى مصانع إنتاج متواصل لخطاب التحريض. من لا ينتبه لهذه الآلية يقع ضحية لها، إذ نجد مثلاً أن كثيرين من أنصار أي سلطة أو أي تيار سياسي يتحدثون بحدة تحريضية ضد منتقديهم، معتبرين أن الدفاع عن شخص أو مؤسسة أهم من الدفاع عن الحقيقة أو المصلحة العامة.
ليس تقديس الأشخاص وحده ما يغذي خطاب الكراهية، بل أيضاً موجات التطبيل الشديدة التي تحاصر الوعي السوري. نرى مشهداً سريالياً متكرراً حيث تتخذ السلطة قراراً فتنهال الإشادات من البعض بحكمتها الخارقة، ثم ما تلبث أن تتراجع عنه لتتسابق من جديد جوقة المصفقين لتبجل “عبقرية التراجع الاستثنائية”! هذا التناقض يغذي عقلية الانقياد الأعمى ويحوّل المجتمع إلى مسرح صراع بين من يصفقون، ومن يجرؤون على الاعتراض فيواجهون بسياط التخوين والتحريض.
من المفيد هنا التذكير بأن تقديس الأشخاص وموجات التطبيل ليسا ظواهر سورية فريدة، بل جزء من آليات المجتمعات التي تمر بأزمات هوية أو انتقالات سياسية حادة، لكنها في الحالة السورية تتفاقم لأنها تتداخل مع تراث عميق من الخوف الجماعي والتجارب المتراكمة في القمع والاستبداد. نقد السلطة، أو حتى نقد الزعيم المحلي أو شيخ العشيرة أو رجل الدين، يصبح نوعاً من “الخروج من الجماعة” وتهديداً مباشراً لهوية المجموع، وفي مثل هذا السياق، فإن مواجهة خطاب الكراهية تتطلب أولاً تفكيك هذه الأوثان، لأن أي مشروع لمصالحة وطنية أو إعادة بناء مجتمعي لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار القداسة الكاذبة، سواء لقداسة الأشخاص أو قداسة الخطابات العصبوية نفسها.
هربرت بلومر، عالم الاجتماع الأميركي ومؤسس النظرية التفاعلية الرمزية، قدّم مفهوم “تهديد الجماعة” لتفسير كيف يشعر الأفراد بأن مواردهم أو مكانتهم مهددة بوجود مجموعات أخرى، مما يزيد من احتمالات التحريض والعداء الاجتماعي. بحسب بلومر، فإن هذه الديناميكية لا تعتمد على التهديد الحقيقي بقدر ما تعتمد على تصورات جماعية متخيلة، تتحوّل بسرعة إلى مبررات لصنع أعداء وهميين وتعزيز الكراهية المتبادلة.
في بعض الأحيان، أصبحت قوالب التخوين جاهزة ومعلبة لكل من يتجرأ على التعبير، حتى الفنانين القديرين مثل سميح شقير لم يسلموا منها. هذا الفنان الذي لطالما غنى لسوريا الثائرة، وللكرامة والحرية، صار هدفاً لحملتين من خطاب الكراهية، آخرهما مع إطلاقه أغنية “مزنّر بخيطان”. وماذا كان ذنبه؟ أنه رفض الانجرار وراء غوغائيات اللحظة وأصرّ أن يكون صوته دائماً فوق جهل المتعصبين واستبداد الطغاة. ظاهرة التخويف الجماعي اليوم لا تستثني أحداً، فكل من يرفض الانخراط في جنون الشتائم والولاءات اللحظية يُتهم فوراً بأنه “فلول”، أو يباغته السؤال المعتاد “أين كنتَ من 14 سنة؟”. النساء، تحديداً، يدفعن الثمن الأغلى هنا، لأنهن في كثير من الحالات الأكثر عرضة للترهيب الرقمي، وهن أيضاً الأكثر صمتاً، إلا إذا كنا يتبنين الخطاب الأكثر شيوعاً ذاته فيمارس بعضهن نفس خطاب الكراهية وبقسوة حتى تجاه النساء الأخريات المعنفات ليشاركن في إسكات الأصوات المخالفة لهم/لهن.
الاستهداف لا يطول فقط آراء النساء السوريات السياسية أو الاجتماعية، وإنما التركيز المهين على أجسادهن، وتشويه صورهن وابتزازهن، بل وحتى تركيب صور مفبركة تسيء إليهن بهدف إذلالهن علناً وهذا ما يجب أن يكون مرفوضاً أياً كانت مواقفهن. ما نشهده هنا هو منظومة من العنف الرقمي المركب، تنشط فيها عصابات إلكترونية بلا رادع، لتدفع المرأة خارج المجال العام وتجعلها أسيرة الخوف، وتمنعها من التعبير والمشاركة.
علينا أن نقولها بوضوح وبلا مواربة؛ إن استهداف المرأة عبر جسدها هو مرآة لانهيار أخلاقي وسياسي يضرب أعماق المجتمع. هذا النوع من العنف الرقمي يفتح الباب أمام أخطر الأشكال والمتمثل بعنف سياسي موجه على أساس النوع، يُضاف إلى منظومات العنف الاجتماعي السائدة، ليكمل دائرة الإقصاء الممنهج ضد النساء وضد كل من يدافع عن قضاياهن ومواقفهن أو يتضامن معهن.
وفي خضم التحريض الذي اجتاح صفحات التواصل الاجتماعي السورية، وجد كثير من السوريين أنفسهم في موقع صعب، فهم ليسوا مع الخطاب التحريضي، ولا منخرطين في ماكينة الشتم والكراهية، لكنهم مع ذلك متعبون ومُنهَكون. هذه الفئة التي تحمل عبء المراقبة الصامتة وتشعر بثقل الانسحاب التدريجي من الساحة الرقمية، لأن المشهد بات خانقاً. ليس من الطبيعي ولا المقبول أن يصل الانقسام في الخطاب إلى درجة تجعل الأفراد يشعرون أن وجودهم في الفضاء العام ولو كمتابعين، بات خطراً على صحتهم النفسية وسلامتهم الاجتماعية. النتيجة هنا تفكك روحي وجماعي، وتهديد صريح للسلم الأهلي، لأن خطاب الكراهية والتحريض إذا استمر، فسيتحوّل إلى عدوى مجتمعية تنفجر في لحظة أزمات لاحقة بحدة وتأثير ربما أعظم من كل ما رأيناه سابقاً.
ما نشهده اليوم في سوريا هو تهديد مباشر للسلم الأهلي، لأن الخطاب الرقمي عوض أن يصبح مساحة لإعادة بناء النسيج المجتمعي، صار أداة تفتيت إضافية. لدينا ثقافة ثأر عميقة تُترجم حتى في طريقة تعبيرنا على صفحات التواصل الاجتماعي، فأغلب النقاشات والخلافات تتحوّل إلى معركة وجودية، وكأن السوري لا يستطيع التعبير عن غضبه أو ألمه أو رفضه واستنكاره أو رأيه وموقفه إلا عبر تحويله إلى ساحة تصفية حسابات. نحن نندفع نحو الرغبة في الانتقام من الآخر، حتى لو على حساب كرامتنا وإنسانيتنا ووطننا نفسه. هذا الانفجار العاطفي يأتي من تاريخ طويل من القمع والتأزيم، لكنه في الوقت نفسه لا يعفي الأفراد من مسؤولياتهم؛ فنحن اليوم بأيدينا نعيد إنتاج أيديولوجيا الكراهية بدل الخروج منها.
من المهم الإشارة إلى أن حماية المجتمع من خطاب الكراهية لا تعني المساس بجوهر حرية التعبير، بل تستدعي تطبيق مبدأ “الحد المعقول” الذي تحدّث عنه الفقيه القانوني الأميركي رونالد دوركين، والذي يرى أن الحرية لا تصبح مطلقة إذا ما وصلت إلى نقطة تهدد فيها الحقوق الأساسية للآخرين بالسلامة والكرامة.
علينا أن نعترف بجرأة بأن خطاب الكراهية في سوريا ينمو على أرضية عدم احترامنا للاختلاف، وإنكارنا لحق الآخر في أن يحمل رأياً معارضاً، حتى لو كان ذلك الرأي يخالف السائد والمقبول شعبياً لأسباب ووقائع يطول شرحها. إن جرأة البعض على إطلاق الصفات الجاهزة، ووصم خصومهم بها بلا تروٍّ أو مساءلة ذاتية، هي طعنة في خاصرة أي مشروع وطني يسعى إلى بناء وطن متماسك لا يُقصي أبناءه ولا يشيطن المختلفين.
إذا واصلنا الانحدار في هذا المسار، فلن يكون بمقدور حتى أولئك الذين اختاروا الوقوف على الحياد، أو اتخاذ المواقف المتوازنة، أن يظلوا صامتين أمام موجات التحريض والوصم. وما لا ينبغي أن نستهين به أبداً هو الأثر العميق الذي يتركه خطاب الكراهية في نفوس جيل الشباب السوري، الجيل الذي ينمو اليوم وسط بيئة رقمية هشة، تنتقل فيها موجات الكراهية والتحريض بسرعة خاطفة ليشارك فيها، في ظل غياب قواعد واضحة لاستخدام مسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.
لقد علّمنا التاريخ، من رواندا إلى يوغوسلافيا، أن الصمت أمام خطاب التحريض هو مشاركة غير معلنة في الجريمة. من لا يرفع صوته اليوم ضد الشيطنة والتحريض والتخوين، سيجد نفسه غداً وحيداً أمام آلة الكراهية، تماماً كما وصف القس الألماني نيمولر زمن النازية: “عندما جاؤوا ليأخذوني، لم يكن هناك أحد يدافع عني”.
تلفزيون سوريا
———————————–
سؤال يتكرّر في كل مناسبة.. كيف نعرف المتورطين بارتكاب جرائم؟/ نور الخطيب
2025.05.09
بعد سقوط النظام السوري، تدخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها العريض هو العدالة الانتقالية، والبحث عن الحقيقة، والمحاسبة، ثم المصالحة.
لكن هذه المرحلة، التي من المفترض أن تؤسس لثقافة جديدة تقطع عقوداً من الإفلات من العقاب، تُواجهها ظواهر مقلقة، أحدها تكرار ظهور شخصيات من الحكومة الانتقالية أو مسؤولين في مؤسسات عامة في صور أو لقاءات مع أشخاص متورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، أو ارتبطت أسماؤهم بممارسات تعذيب واعتقال تعسفي، أو حتى تورطوا بشكل مباشر في جرائم قتل ومجازر.
وجوهٌ قديمة تعود، أسماء مألوفة تظهر من جديد في صور ولقاءات واجتماعات، إلى جانب مسؤولين جدد يفترض أنهم يمثلون القطيعة مع القسوة.
حين تواجه هذه الشخصيات بعاصفة من النقد على وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي الإجابة السهلة: “لم أكن أعرف من هو.”
“لم أكن أعرف أنه متورط.” وكأنّ التورط بجرائم ضد الإنسانية أمرٌ يمكن إخفاؤه بسهولة، أو أنه تفصيل هامشي يمكن تجاوزه باسم المجاملة الاجتماعية أو العفوية أو “عادي كان موجود وما عرفنا مين هو”.
لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح في هذا السياق هو: كيف نعرف المتورطين بارتكاب الجرائم؟ ولماذا نختار ألا نعرفهم؟
ليس صعباً… حين تكون هناك إرادة
في زمن الثورة، تحوّلت الذاكرة إلى أرشيف حيّ: تقارير، شهادات، صور، مقاطع فيديو، مذكرات قضائية وقوائم عقوبات، سرديات متداولة في الحارات والمخيمات والمنفى. لا أحد بحاجة إلى أكثر من دقائق بحث ليعرف من هو هذا الشخص الذي يقف بجانبه، وماذا فعل، وماذا رأى الناس فيه.
مع مرور أكثر من عقد على انطلاق الثورة السورية، تراكمت كمية ضخمة من التوثيق الحقوقي، سواء من منظمات محلية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أو منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أو من المبادرات المدنية التي نشطت في أرشفة الشهادات، والوثائق، والصور، والفيديوهات. أسماء الآمرين والمنفذين والداعمين لم تعد مجهولة كما كان الأمر في سنوات الرعب الأولى. يكفي اسم بسيط وبحث دقيق حتى تظهر الخلفية الكاملة لأغلب الأفراد المشتبه بتورطهم.
فهل المسؤول، الذي يمتلك فريقاً ومستشارين وإمكانات، يعجز عن القيام بهذا البحث البسيط؟ أم أن المسألة ليست جهلاً بقدر ما هي تجاهل؟ هل نحن أمام قلة معرفة أم قلة مسؤولية؟
لكن المعرفة هنا ليست مجرد معلومة… إنها موقف. قرار داخلي بألا نشارك الجلاد مكانًا، ولا نظلله بابتسامتنا، ولا نمدّ له يدًا لم يمدّها أبدًا لضحاياه.
أن تقول “لم أكن أعلم”، وأنت مسؤول عن رسم ملامح المستقبل، لا يعفيك. بل يفضح اختلالًا في البوصلة الأخلاقية. لأن من يُكلّف بالمسير نحو العدالة، لا يملك رفاهية التغافل.
ما الفرق بين “الجهل” و”التواطؤ”؟
في بعض السياقات، يمكن اعتبار الجهل بالمعلومة عذراً، أو ضعفًا إنسانيًا، لكن حين يكون الشخص مسؤولاً في مرحلة انتقالية، مرحلة ما بعد الكارثة، التي من المفترض أنها تؤسس لعقد اجتماعي جديد وأن تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس العدالة، فإن الادعاء بالجهل يُصبح شكلاً من أشكال التواطؤ الناعم، أو الحد الأدنى من التقاعس عن أداء الواجب، وتطبيع صامت مع ما لا ينبغي تطبيعه.
أن يظهر مسؤول في صورة مع شخص ارتكب جرائم ضد المعتقلين، أو كان جزءاً من أجهزة أمنية مارست الإبادة بحق المدن، أو تورّط في سرقة أموال السوريين خلال الحرب، ثم يقول: “ما كنت بعرف مين هو” , فهذا ليس عذراً، بل إهانة للعدالة، وعبور فوق ذاكرة الضحايا. وتجاوزٌ لمبدأ أساسي في العدالة الانتقالية: عدم إعادة دمج الجلاد قبل كشف الحقيقة.
وهنا نلامس سؤالًا أشد قسوة: هل نحن في طور إعادة إنتاج النظام، ولكن بوجهٍ ناعم؟ هل نحن نحمل على أكتافنا نفس الجلادين، ولكن في غلاف جديد اسمه “التسامح” أو “الانفتاح” أو “الحياد”؟
من هم المتورطون؟ وكيف نعرفهم أو نراهم؟
تحديد المتورطين ليس مهمة مستحيلة، يمكننا تحديد المتورطين من خلال عدة مصادر ومؤشرات يمكن الاعتماد عليها، منها:
1. الرتب والمناصب الأمنية والعسكرية: أغلب من شغلوا مناصب قيادية في أجهزة الأمن أو في الجيش السوري خلال سنوات القمع الدموي، يحملون مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الجرائم التي ارتُكبت. لا يمكن مثلاً تبرئة رئيس فرع أمني أو ضابط كبير في فرقة عسكرية كانت معروفة بمجزرة معينة.
2. المذكّرات القضائية الدولية: مثل التي أصدرتها دول أوروبية بحق عدد من ضباط النظام. هذه مراجع قانونية متاحة للعموم.
3. تقارير المنظمات الحقوقية: وهي متوفرة على المواقع الرسمية، ومرتبطة عادةً باسم الشخص وانتهاكاته وتاريخه.
4. الشهادات الميدانية: آلاف الناجين من المعتقلات ومن مجازر النظام السوري أدلوا بشهاداتهم، وذكروا أسماء ضباط وسجّانين ومحققين وميليشيات. هذه الشهادات باتت مراجع أساسية في العدالة الانتقالية.
5. الأرشيف البصري والصوتي: مقاطع الفيديو والتسجيلات التي وثّقت التعذيب أو القصف أو الإعدامات، وتُستخدم اليوم كأدلة في محاكم أوروبية.
إذن، الحديث عن صعوبة معرفة من هو المتورط لا يستقيم. بل هو تهرّب من المسؤولية. وليس مبررًا أخلاقيًا أو سياسيًا، ونحتاج فقط، إلى وعي. إلى حسّ داخلي يرى ما وراء الوجوه. نعرف المتورطين من رتبهم، من مناصبهم، من ماضيهم، من تقارير الحقوقيين، من شهادات الأمهات، من وجوه المعتقلين الذين خرجوا وعليها آثار الخوف. هناك من لا يحتاج إلى دليل مكتوب. مجرد ظهوره يوقظ فينا ذاكرة الرعب. هؤلاء، لا مكان لهم في المساحات التي تُبنى فيها حياة جديدة.
هل هناك قائمة سوداء؟ الذاكرة الجمعية أهم من القوائم
لا توجد “قائمة رسمية” بعد تضم كل المتورطين، لأن العدالة في سوريا لم تكتمل بعد، ولم تُفعّل المؤسسات القضائية على مستوى وطني. لكن هناك ما يشبه “الذاكرة الجمعية”، مبنية على وثائق وشهادات ودعاوى. وعلى المسؤولين في هذه المرحلة أن يتعاملوا مع هذه الذاكرة بمنتهى الجدية.
إن كنت مسؤولاً في مرحلة ما بعد النظام، فإن من أولوياتك أن تعرف من تصافح، ومن تلتقي، ومن تجلس معه، ومن تنشر صورك إلى جانبه. لأنك لا تمثّل نفسك فقط، بل تمثّل جرحاً وطنياً مفتوحاً لا يحتمل مزيداً من الاستفزاز.
نحن لا نبحث عن انتقام… بل عن ذاكرة لا تُداس
العدالة الانتقالية ليست خريطة طريق قانونية فقط، بل أخلاقٌ جمعية. هي طريقة في النظر إلى أنفسنا: من نُكرّم؟ من نُحاسب؟ من نُنسّي؟ ومن نُعيد إلى الواجهة؟ وحين نعيد من تلطخت أيديهم إلى الأماكن العامة، دون حساب، فإننا لا نغفر… بل نمحو.
الضحايا لا يُقتَلون فقط في السجون، بل يُغتالون مرة أخرى حين تُلتقط صورة علنية مع جلادهم، ويقال لهم بعدها: “عادي، لم نكن نعرف”.
العدالة تبدأ بالانتباه
نحن في مرحلة دقيقة وحرجة. والانزلاق إلى “التسامح الاجتماعي” مع الجلادين، تحت شعارات الوحدة أو الواقعية أو الحياد، لا يخدم إلا تكريس ثقافة الإفلات من العقاب. لا يمكن بناء سوريا الجديدة بوجوه النظام القديم، ولا يمكن ترميم الثقة مع المجتمع دون احترام ذاكرة الضحايا.
العدالة ليست فقط محكمة وحكم، بل وعي ومسؤولية وحساسية أخلاقية. وكل مسؤول اليوم عليه أن يسأل قبل أن يلتقط صورة: هل من إلى جانبي يحمل على يده دماً.
ربما لن تصل المحاسبة غدًا. وربما لن يمثل كل مجرم أمام قاضٍ. لكن العدالة الحقيقية تبدأ من أمر أبسط: من ألا نُخون الذاكرة. من أن لا نضع المجرم في مكان البطل. من أن نُصغي لصوت من كُسرت أرواحهم، ونقول لهم: “نحن نعرف. ولن ننسى.”
العدالة تبدأ من الانتباه، من الفطنة، من الحساسية الأخلاقية. أن تعرف من تصافح، ومن تجلس بجانبه، هو اختبار يومي للصدق مع الذات. في هذه المرحلة، لا أحد محايد. الصمت موقف. الجهل موقف. المجاملة موقف.
لا تُبنى سوريا جديدة بوجوه من دمّرها. ولا تُرمّم ثقة الناس بدولة، إذا رأوا نفس الوجوه التي كانت تقود المذابح، تعود لتجلس على المقاعد الأمامية.
في النهاية…
لسنا بحاجة إلى محاكم فقط. نحن بحاجة إلى ذاكرة حية، وإلى من يحملها بصدق ومسؤولية. نحن بحاجة إلى مسؤولين لا يقتلون الضحايا مرة أخرى، بابتسامة أو صورة أو عذر واهٍ. لأن من يقف بجانب القاتل، يقف في الجهة الخطأ من التاريخ. ولأن الدم لا يُغسل بالتجاهل. ولأن بعض الأيادي…لا يجب أن تُصافَح.
————————————
بعد ستة أشهر من التحرير المبارك
١- من الضروري إعادة كتابة الإعلان الدستوري من لجنة أعمق تخصصاً وتحظى بشجاعة سياسية أكبر .
٢- المجتمع والدولة السورية التي هي ملك للشعب ليست حقل تجارب وصار الوقت مناسباً لتوسيع الاستفادة من الكفاءات السورية.
٣- الوطنية نوعان شيطانية رسمتها أيدي سايكس بيكو ، ووطنية تلم الناس لايمكن لمن يحب بلده أن لايعمل من أجلها.
٤-المشروع الأممي الذي ممكن أن تحمله سورية بخصوصيّتها الفريدة يقوم على مد الجسور مع الأمم والتعارف وبناء الأمن والسلام
٥- ترحل الأنظمة ويجب على الشعوب ان لاتحمل عداواتها ومكونات المنطقة الأربعة وهي الكورد والترك والفرس والعرب مدعوة لبناء نموذج حضاري يحمل الاستقرار والازدهار.
٦- التطبيع القسري مرفوض والشعوب هي التي تقرر بوصلتها وليس الحكومات، وقد فشلت جميع أنواع التطبيع بالإكراه.
٧- المقاومة عقيدة وفكر وليست مجرد سلاح والسلام مطلب ضروري في حال التكافؤ والندية (مثل تحريم السلاح الكيماوي من كل الأطراف).
٨- سحب السلاح يجب أن يكون بالتوازي ومن كل المناطق.
٩- امتلك الشعب السوري بمجموعه خلال كفاحه ضد الديكتاتورية خبرات يمكنها التعامل مع أكبر امبراطوريات العالم.
١٠- النسيج الاجتماعي السوري من أبدع مكونات الأرض والعبث به جريمة بحق الجميع.
١١- المكون السني ليس طائفة ولا أقلية ولا أكثرية بل هو الملاط والأساس الذي يجمع بين كل المكونات وتقزيمه وحشره في مسارات ضيقة تآمر عليه وإشعال للحرائق وسيرتد بشكل حاد على كل العابثين.
١٢- الكفاءات الاقتصادية السورية الحرة هي التي تستطيع إخراج سورية من الحصار الاقتصادي فهي تمتلك الخبرة والعلاقات الدولية والشراكات الفعالة.
١٣- وظيفة الأجسام الدينية لم قلوب الناس وجمعهم على المشتركات وإبراز الخصائص المميزة لانتمائهم بعيداً عن التحريض وزرع العداوات والكراهية .
١٢-العدل أساس الملك، والعدالة الانتقالية أحد مساراتها الضرورية التي ينتظرها السوريون.
١٣- المشروع القائم لبناء سورية يجب دعمه والتعاون مع المخلصين فيه وليسوا بقلة وتقويم مساره منا جميعاً حتى ينجح فقد يكون لنا جميعاً السوريين قارب النجاة الأخير .
أحمد معاذ الخطيب
—————————–
==========================