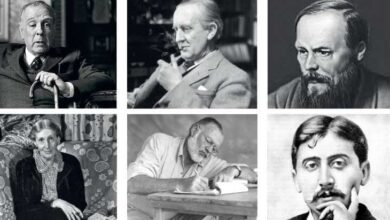أفول الجماعات الأدبية/ علي سفر

17 مايو 2025
في أثناء تصفّح صفحات فيسبوك، يمرّ القارئ بظاهرة غريبة تتمثل في وجود صفحات تحمل أسماء أدبية، يدّعي أصحابها أنها “أكاديميات إبداعية” تحمل تراخيص ما، وتنسج علاقات تمتد من الجامعات الرصينة إلى المراكز البحثية الكبرى. يقوم القائمون عليها بمنح المنتسبين شهادات تعترف بهم أدباءً “لا يُشق لهم غبار”!
يسأل القارئ: من هؤلاء؟ ولا أحد يقدّم الجواب سوى الواقع ذاته! فهذه المؤسسات الوهمية، المنشأة في العالم الافتراضي، ليست سوى دكاكين يفتتحها أصحابها إما تعويضًا عن فشلهم في دخول عالم الإبداع التقليدي، فيحاولون إنشاء عالم موازٍ، أو بحثًا عن واجهات للاستعراض والتكسب المعنوي، وتحشيد مئات الأسماء التي تكتب كلامًا مكرّرًا، وتبحث بدورها عن مساحات للنشر.
تكرّست هذه الظاهرة خلال عقد ونصف، ومع توفّر المنصات الرقمية المتطوّرة، بات الفاعلون فيها يمتلكون فرصًا متعدّدة للحضور بالصوت والصورة، عبر منصة “تيك توك” وغيرها. لكن هذا كله لم يُساهم في دفع منتجات المشاركين نحو جمهور القرّاء أو نقّاد الأدب، وذلك لسبب رئيس: أن أغلب ما يُحتفى به هنا ليس سوى كلام عادي، تظهر فيه ظلال واضحة لتجارب أدبية مكرّسة.
غير أن هذا لم يوقف الساعين إلى ارتقاء درجات الشهرة، بل زاد من إصرارهم على تكرار الفعل ذاته، مع الشكوى الدائمة من أن الصفحات الثقافية مغلقة على “المكرّسين”، وأنها محكومة بـ”الشللية”.
يرى بعض المراقبين أن أسباب تفاقم هذا النشاط تعود إلى تضخم “الأنا” الأدبية في ظل الفراغ المؤسّساتي، وتلاشي آليات الفلترة الأدبية أو الإبداعية التي كانت تفرضها المجلات والنقّاد، إضافة إلى تركيز “المبدع” على تسويق ذاته، بدلًا من تمثّل دوره كمشروع جمالي أو فكري. وهنا يتقاطع هذا السلوك مع ما سمّاه بيير بورديو بـ”رأس المال الرمزي”، حين يُستبدل الفعل الثقافي الحقيقي بـ”الظهور” و”الاعتراف الخارجي”، حتى وإن كان وهميًا.
رصد هذه الظاهرة يعيدنا إلى سؤال الجماعات الأدبية في المنطقة العربية، حيث إن التاريخ يربط ظهورها إما بأسباب جغرافية، مثل “الرابطة القلمية” التي تأسّست في نيويورك عام 1920، و”العصبة الأندلسية” في ساو باولو بالبرازيل، مطلع 1933، أو بأسباب إبداعية تتعلّق بتبنّي مجموعة من الأدباء أسلوبًا محددًا، كما في جماعة “مجلة شعر” التي تأسّست عام 1957، ونبضت بشعارات الحداثة، فصارت واجهتها العربية الأبرز، وكذلك جماعة “كركوك” العراقية التي عملت على تعميق تيار الحداثة في فضاء تجريبي خاص.
وفي قراءة أعمق لآليات ظهور هذه الجماعات، فإن التحليل الذي يربط الإبداع بتحولات الواقع يرى أن هذه الظواهر تنشأ على هامش التحولات العميقة التي تشهدها مجتمعاتها. وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار الجماعات الأدبية حاملةً لرؤى تسعى إلى التعبير عن وجهة نظر مختلفة حيال ما يجري في الواقع السياسي والاجتماعي وارتداداتهما في الحيّز الثقافي. وحتى تلك التي نشأت في المهجر، إنما كانت صدى لتحولات مرحلة ما بين الحربين العالميتين.
وعبر هذا التأريخ المشبع بروابط واضحة بين التيارات الأدبية والواقع المجتمعي، صار لدى القارئ العربي تاريخ أدبي موازٍ للتاريخ السياسي. ورغم أن مساحة تأويل هذه الظواهر من خلال تحليل نتاجات أصحابها لا تزال حتى اليوم شاغرة، وتطالب النقّاد والدارسين بالمزيد، إلا أن الثابت أن سلسلة طويلة من الجماعات ظهرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وكان أغلب الأدباء المكرّسين في وقتنا الحالي أعضاء فيها أو على تماس معها.
أُصيبت هذه الجماعات، منذ تسعينيات القرن الماضي وصولًا إلى نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، بانكماشٍ واضح، يُعزى إلى خلل أصاب الواقع ذاته: فبعد اجتياح جيش صدام حسين للكويت، حدث انهيار كبير في الأفكار القومية العربية، كما شكّل انهيار الاتحاد السوفييتي صدمة كبرى لتيار واسع من اليساريين العرب، ما جعل فكرة التجمع وتأسيس التكتلات عرضةً للشك في جدواها.
لكن هذا لم يمنع بعض التجارب قصيرة العمر من التشكل، مثل جماعة “مجلة ألف” السورية، التي ظهرت في بداية التسعينيات، وحاول أصحابها التحايل على القمع وتكميم الأفواه، والتصرّف خارج إطار المؤسسات الرسمية كوزارة الثقافة واتحاد الكتّاب العرب، فنشروا نصوصًا مغايرة في 23 عددًا من المجلة، قبل أن تُمنع من التوزيع في أغلب البلدان العربية وتتوقّف.
إذا جاز لنا الاعتداد بفكرة طرحها الناقد الفرنسي الشهير رولان بارت، ومفادها أننا لا نكون بحاجة إلى طليعة إلا عندما يكون المجتمع في مأزق، فإن سلسلة المآزق التي تعرّضت لها بلدان “الربيع العربي” منذ عقد ونصف، نتيجة سعي البُنى العميقة المكرّسة لكبح جماح القوى المجتمعية الراغبة في تغيير الواقع السياسي، كان يُفترض أن تفضي إلى ظهور جماعات أدبية تتبنّى شعارات مختلفة عن تلك التي سادت في أزمنة سابقة.
لكن الواقع يكشف أن همة المثقفين ورغبتهم في الاجتماع تحت أطر محددة عانت من نكوص كبير، خنق أنفاس الفكرة ذاتها، فلا نعثر على جماعة تحاول الظهور بحمولة فكرية عميقة، تشتبك مع الواقع وتحلّله.
ولا يخلو المشهد من اجتهادات شبابية تظهر وتنطفئ سريعًا، رغم ما تحمله من بذور واعدة، كجماعة “مليشيا الثقافة”، التي ظهرت قبل نحو عشر سنوات، واشترك فيها شعراء عراقيون (مازن المعموري، كاظم خنجر، علي ذرب، محمد كريم، أحمد ضياء، علي تاج الدين، وسام علي، أحمد جبور، وخالد الشاطي)، وحاولوا عبر نشاطها تقديم صياغة بصرية تناسب الواقع المستجد في فضاء الشبكة الإلكترونية، احتجاجًا على واقع العراق بما فيه من خراب وقتل وانقسام طائفي. ولكن لماذا لم تعد فكرة “الجماعة الأدبية” تثير اهتمام الأدباء الشباب، وحتى أصحاب التجارب المكرّسة؟
الإجابة تقف عند عدة احتمالات، تنطبق على النشاط الإبداعي في مختلف أنحاء العالم، مثل تفكك الأطر الإيديولوجية الكبرى، وزوال أهمية المنابر الورقية، وتصاعد الفردانية الثقافية، وسيطرة وسائل التواصل التي تعزّز الصوت الفردي على حساب المشاريع الجماعية.
كما أن تحوّل النشر إلى مساحة رقمية مفتوحة قلّل من مركزية الجماعات. ويُضاف إلى ما سبق، وضمن خصوصية السياق العربي، أن التفكير في القطيعة الإبداعية مع ما سبق، والتفكير في بنى جديدة، لم يعد حاضرًا في المشهد العام؛ فلا نرى بيانات شعرية أو بيانات جمالية، ولا نسمع أصواتًا تعارض نوعًا إبداعيًا لصالح آخر، بل إن الجميع يعيش حالة “تجاور” لا تستدعي الصخب، ولا تطلب المعارضة.
كما أن السلطات القائمة لم تواجه الأشكال الحداثية (قصيدة النثر، الرواية المفتوحة، التعدّد الصوتي…)، بل طَبّعت معها، حتى صارت دراستها جزءًا من النشاط الأكاديمي، ولم تعد ناتئة في نظر العقل التقليدي. وتحولت، بمرور الوقت، إلى مادة مقبولة ضمن شروط السوق (الناشر، الترجمة، الجوائز، المهرجانات). وأُضيف إلى هذا الواقع دعم المؤسسات التمويلية للكتّاب، عبر دعوات التفرغ والإقامات الإبداعية، في سياق يحتفي بالفردية.
* شاعر وكاتب سوري
العربي الجديد