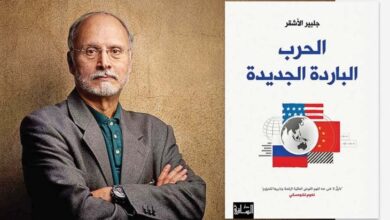تمثّلات “الجسد في رواية الحرب السورية” بحث وداعي من حسان عباس/ نجوى قندقجي
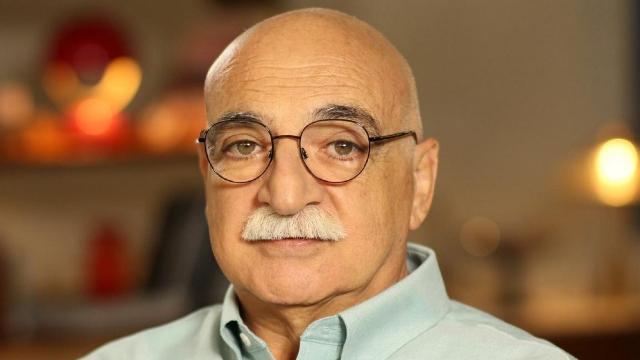
لا يكتسب إصدار كتاب الباحث حسّان عباس “الجسد في رواية الحرب السورية” الصادر عن منشورات “المعهد الفرنسي للشرق الأدنى” معنى إنسانياً فحسب، كونه ظهر للنور قبل أسبوع فقط من انطفاء نور حياة الباحث، بل معنى فكرياً وتنظيرياً يضيفه إلى عالم القراءة الأدبية على صعيد الرؤية والتحليل والتأويل، بما يجعل هذا البحث جديراً بقراءة جديدة، وكأنّه توصية الباحث الفكرية بألا نهاب المزيد من الجدل المعرفي.
البنية البحثية
تطغى السمة الأكاديمية كأساس في تناول الموضوع ومنهجية التحليل كما يتجلى في بنية الكتاب، استهلالاً من المقدمة حيث يحدد الباحث التعريفات لمفردات الموضوع المعنونة له، واستعراض أسباب اختيار الروايات المدروسة (عينة البحث التطبيقية)، وأسئلة البحث وأهميته، إضافة إلى اختياره المنهج السوسيونقدي ليكون تأسيسياً في تحديد مسارات البحث التحليلية.
ونحو تعريف رواية الحرب، يشير عبّاس أنه لا يقصد رواية محددة بل هي “الرواية السورية التي بنت حكاياتها على أرضية الحرب في سوريا والتي لا يمكن فهم وقائعها ودقائقها وطبائع شخصياتها إلا بدلالة هذه الحرب”، من دون أن ينفي صعوبة توسيم الحرب السورية، رافضاً ما أُطلق عليها دعائيّاً وبحثياً إما “الحرب الطائفية” أو “الحرب المذهبية”، بل يراها حرباً بدأها نظام ضد شعبه، ما لبثت أن تحولت إلى مشهدية حربية عبثية شديدة المأساوية، لتعدد المشاركين فيها من جيوش مختلفة ومرتزقة وجماعات جهادية، وتبقى الحرب ليست بذاتها هدف الدراسة بل ستظهر دوماً من خلال التعالق معها عبر تمثّلات الجسد أدبياً للشخصيات الروائية.
تحضر أحداث الحرب في ثلث النتاج الروائي السورية، وتشكّل الروايات الخمس عشرة المختارة بما يكفي لتمثيل نسبة عشرة بالمئة من هذا الإنتاج الضخم، إذ وصل عدد الروايات بين عامي 2011 و2018 إلى 153 رواية (وُضعت عناوينها في ملحق بآخر الكتاب)، والروايات المختارة هي:
“الذئاب لا تنسى” للينا هويان الحسن، “المشاءة” لسمر يزبك، “بانسيون مريم” لنبيل الملحم، “السوريون الأعداء” لفواز حداد، “أيام في بابا عمرو” لعبد الله مكسور، “عائد إلى حلب” لعبد الله مكسور، “الموت عمل شاق” لخالد خليفة، “الخائفون” لديمة ونّوس، “الذين مسّهم السحر” لروزا ياسين حسن، “نزوح مريم” لمحمود حسن الجاسم، “موسم سقوط الفراشات” لعتاب شبيب، “مفقود” لحيدر حيدر، “جهنم صغيرة لهذه الجنة” لعادل محمود، “بائع الهوا” لجميل نهرا و”طابقان في عدرا العمالية” لصفوان إبراهيم.
وهو خيار انتقائي لا يخلو من القصدية (الإرادوية- كما يسميها)، تمّ للأسباب التالية:
– اعتماد البحث المتن النموذجي وليس البانورامي.
– مرحلية البحث لعدم اكتمال المشهد النهائي للرواية كون أحداث الحرب لم تنته.
– شمولية الاختيار عبر تجنّب التأثيرات العاطفية أو النقدية أو السياسية أو الدعائية.
شيكو… الخروج من الجسد “التخين” كأداة للضحك
تشظّي المنتظِرين… كي لا ينتقل العفن إلى كامل الجسد السوري مرةً تلو مرة
مسافر منتصف الليل… الجسد والكاميرا في الرحلة الجحيمية نحو الحرية
الجسد والأدب
ينطلق عباس في بناء رؤيته على اعتبار أنه “لا أدب بدون جسد، بدون أجساد، ما دام الأدب يحكي، يروي، حكاياتٍ تحتاج إلى فاعلين لا يمكنهم إلّا أن يتمثّلوا بوجود مادّي يسمح بتتبع الحركات والأفعال التي يأتونها، والعلاقات التي يبنونها، والتي ترسم بمجملها نسيج الحكاية”، يصبح الجسد وسيط التمثيل الأدبي الأساسي ومادته.
تبرز أمام حتمية تواجد الجسد في الكتابة الأدبية المعطيات المستحدثة التي تفرزها صورة الجسد نتيجة التأثيرات الثقافية المختلفة حسب بنية المجتمعات، إذ يواجه الباحث تلك الدراسات التي تتبنى أن الحضور الجسدي يرتبط فقط بالفردانية في ثقافة المجتمعات الغربية، مع بروز الفلسفة الوضعية العلمية أمام انحدار الثقافة الشعبية، في حين تشهد المجتمعات العربية تراجعاً في الحداثوية مع تنامي التعصب الأقلوي بمجالاته الدينية والقومية والجنسية، ومع ذلك ضمن رؤية أشمل “ثمة حضور صارخ للجسد المفرد في النتاج الثقافي السوري”، يستدعي الرصد من خلال حصر خصائص الصورة في ثنائية الجسد والروح، وهي ثنائية متلازمة لكنها غير متساوية في المرتبة والقيمة، حيث الروح تسمو في تعبير عن القيم اللامادية، بينما الجسد يمثّل التبدلات المادية، فهو القرين المبتذل للروح.
والخاصية الثانية تظهر في الجسد الملحمي، وهو الجسد المنصهر في الجماعة أو في الجموع التي تتحرك حسب إيقاع متناغم أو عاطفة مشتركة تظهر في حركات الجسد وسماته، أما الخاصية الثالثة فهي الجسد المقموع عند الحدّ من حرية تعبير الفرد بجسده ولا سيّما الحرية الجنسية.
بدأت محاولات كسر التابو الجنسي مع أشعار نزار قباني، ورغم ظهور بعض الإشارات الجنسية في بعص النصوص الروائية والمسرحية، لم يكن الجنس موضوعاً أساسياً في الأدب السوري.
أما إعلامياً فقد قامت السلطات الرقابية بمنع البرامج التلفزيونية التي تعرض هامشاً حرّاً في التعبير الجسدي (مثل برنامج الأغاني الغربية)، ولكن هذا المنع ما لبث أن خرج عن السيطرة وفقد معناه مع فورة الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية.
وفي مواجهة هذا التضييق في الممارسات السلطوية الثقافية والدينية برزت بعض الظواهر الاجتماعية التي تحتفي بالجسد، مثل حلقات الرقص وازدهار عمليات التجميل والاعتناء الرياضي الجسماني والبهرجة المبالغة بها في ثياب المتديّنات، وما هذا حسب عبّاس إلا تعبير عن قوة الحياة في المجتمعات أمام سطوة الثقافات المهيمنة والتي مهما كانت مُحكمة “لا تستطيع أن تقتل توق الناس إلى التحرر منها، فتنتعش أشكال متعددة للمقاومة تبدأ من الزوايا الأقل صدامية (اللباس والطعام والموسيقى والوشم..) لتتفاعل وتتطور وتأخذ أشكال تعبئة مجتمعية وحركات احتجاجية”.
يتناول الباحث صورة الجسد مع بدء الانتفاضة الشعبية عام 2011، من خلال مسارين لا يمنع وجود بعض التناقضات فيما بينهما أن يكونا متلازمين ومتوازيين، وهما المسار الملحمي الذي يجمع الأجساد في كتل موحدة، كما بدا ذلك في المظاهرات الضخمة والتجمعات الشعبية، مثل مظاهرة حماة والحركات الشبابية ذات الطابع الاحتفالي في حمص.
والمسار الآخر هو المسار الفرداني حيث تتجسد حكايا الناس الشخصية في صورة، ولعل أشهرها الصور المدرجة في (ملف قيصر)، وفي المقابل هناك صور آلاف العسكريين المنتشرة في المدن التي كانت تشكّل روافد بشرية داعمة للنظام. أما على المستوى الإبداعي، فيشير عبّاس إلى ظاهرة الشهادات الأدبية الصادرة عن “دار المواطن” والتي أطلقت سلسلة “شهادات سورية” تروي تجارب فردية خلال الحرب.
ومن المُلاحظ تراجع المسار الملحمي لصالح المسار الآخر لدى جميع الأطراف، مع تطوّر العمليات العسكرية والحضور الطاغي لصور الموت والقتل، لتحلّ صورة الشهيد محل صورة الجماعة، إذ انتهى الجسد الجمعي وبات لكل طرف أبطاله وشهداؤه وناسه المميزون.
وتأتي أسئلة البحث: كيف قام الأدب من كل طرف بتمثيل هذه الأجساد؟ هل ظهرت اختلافات في رسم الجسد تتبع الاختلافات في مواقع هذه الأجساد، فلكل خندق طريقته في التمثيل؟ هل انتقل الصراع إلى تمثيل الأجساد ليصبح الجسد هو ساحة قتال؟ ويتبع الباحث منهجية استقرائية تعتمد على حصر التمثلات الجسدية ليتم لاحقاً قراءتها قراءة دلالية مقارنة، لرصد دلالات المظهر الجسدي لدى كل طرف من الأطراف المتقاتلة، كما جاءت في الروايات المذكورة.
سنستعرض الأطر النظرية فقط التي قام الباحث بوضعها، دون الإشارة إلى الروايات المتناولة والتي تتفاوت قي قدر التحليل من محور لآخر، والأمر لا يخلو من الاستثناء.
لا تستطيع المهارة الأدبية مهما بلغت درجتها أن تنجح في تمثيل الجسد أدبياً بكامل خصائصه الظاهرية (الخَلق) والروحانية (الخُلق) الموجودة خارج النص، “فالجسد أكثر فصاحة من اللسان”، لكثافة ما يحمله من دلالات فيزيائية طبيعية، إضافة إلى تلك الدلالات الثقافية، والتي تتفاعل فيما بينها لإنتاج المعنى.
وهذا ما يعطي الجسد دوراً في الحضور المجتمعي، القائم على السلوكيات الفردية التي تمثّل ثقافتها المكتسبة، حيث تتنامى وتتشارك الثقافات في استخدام هذه السلوكيات والتصرفات.
وعلى مستوى المعالجة الأدبية، ورغم أن الأجساد تفرض نفسها على الكاتب، فإنه لا يستطيع إلا أن يكون انتقائياً، وفي الوقت نفسه هو يبني رؤيته الفردية من خلال نظرته الإيديولوجية للعالم الخارجي، في مقاربة بين العالم الحقيقي وتصوراته نحو عالمه الأدبي المتخيّل.
وفي اعتماد مصطلح “المعشّقات- embrayeurs” الذي أطلقه رولان بارت، التي تربط بين الجسد الروائي والجسد الحقيقي، كان لا بد من البحث عن القواسم المشتركة بين الروايات المدروسة لمقاربة الأجساد والتي يطرح الباحث لأجلها مدخلين أساسيين هما: مدخل الخصائص المادية واللامادية التي تعني كلّ ما يتعلق بالشكل الفيزيائي بما فيها الخصائص المادية الثابتة (البدنية: مثل الضخامة والنحول، القوة والهشاشة، صفات الأعضاء والشوارب واللحى) والخصائص غير الثابتة (المنقولة مثل الملابس والحلي والأسلحة).
أما مدخل الخصائص اللامادية فهي الخصال التي لا تُمس كونها لا تتمتع بأي شكل جسماني، مثل الصوت واللغة واللهجة والذاكرة.
البنية البدنية وتعدد الدلالات
تختلف سمات المظهر العام عندما يتمّ نقلها نحو سياق النص الأدبي، حيث تخضع لمخيلة الكاتب الذي يمنحها قيمة معرفية، بعيداً عن ابتذال الواقع وغموضه وبدئيته، ما يدفع الباحث إلى القول “إن الجسد الروائي من حيث المعطيات ذاتها هو نتاج أدبي تساهم الشروط الفكرية والإيديولوجية للكاتب بإظهاره على هذا الشكل أو ذاك”، وهذا ما يدعو للاهتمام بالجسد “الكلّي” (البنية البدنية) وتلك التفاصيل المعبّرة عن كل الجسد/الشخصية (الوجه).
ويقترح لدراسة البنية البدنية التوقف عند أكثر ملامح هذه البنية في التعبير والدلالة، من خلال ثلاث ملامح:
البدانة والنحول: تظهر المماهاة بين حجم جسد الشخصية وموقف الكاتب من الشخصية في معظم الروايات المتناولة، وهذا ما يضعها تحت خانة التنميط، حيث تكاد أغلب الشخصيات التي تتسم بالسمنة أو البدانة هي سلبية أو شريرة أو عدائية، مقابل الشخصيات النحيلة التي يتعاطف معها الكاتب، و”كأن الروائيين ينظرون إلى أجساد شخصيات رواياتهم عبر عدسات مقعّرة أو محدّبة بحسب ما إذا كانوا يتعاطفون معها أو يقفون ضدها أخلاقياً وسياسياً”.
يشير الباحث أن هذا التنميط في رسم صورة الجلّاد/الضخامة مقابل الضحية/النحول، ما هو إلا محاولة لتكريس صورة النظام الوحشية والتي طالت جميع فئات الناس بمن فيهم البدناء.
العضلات المنفوخة والعضلات المفتولة: يقتصر هذا الوصف على الشخصيات الذكورية، ويحمل ثنائية جمالية متناقضة تتمثل في أن العضلات المفتولة تحمل دلالة إيجابي وبينما المنفوخة دلالة سلبية، وكأن المنفوخة تدلّ على اكتساب الحجم هوائياً، ليبدو الجسد غير طبيعي أو انتفخ نتيجة تعاطي الحبوب والمنشطات مع العناية الفيزيائية الفائقة، ولهذا فالشخصيات المنفوخة هي زائفة وفارغة المضمون.
وتتكرر آلية التنميط من جديد في هذا السياق، في تلازم صفة المنفوخ مع صورة الشبيحة ورجال الأمن كتمثّل لأجهزة القمع، وهذا لا يقتصر على الوضع السوري بل هي شائعة في كل المجتمعات، مستشهداً ما يقول تيودور أدورنو حول الصورة النمطية والتي تلعب دوراً مطمئناً “للفرد الذي يفقد بوصلته في المجتمع، نظراً لأن السيرورات الاجتماعية تخضع لقوانين تتجاوز مقدراته على فهمها”.
الهشاشة والضعف: وهي من صفات البنية الداخلية للشخصيات، مثل عوارض المرض أو العلل النفسية أو إصابة الجسد بالعاهات والتشوّهات، وهو ما يجعل “هذه الأجساد إنما هي معادلات سردية رمزية للفاعلين في الحكاية الأكبر، حكاية الواقع”.
الوجه مرآة الواقع
يمثّل الوجه أداة التفاعل الأساسية لدى الإنسان مع محيطه الاجتماعي مختصراً كامل الجسم، إذ من خلاله تُبنى الجسور التواصلية بين الناس، بكل احتمالاتها وتنوعاتها بين التفاهم والتناغم أو التنافر والشقاق. وفي هذا السياق يتجه الباحث للتركيز على العيون والزيادات الشعرية (الشوارب واللحى).
العيون: تحظى العين بمكانة رفيعة في اللغة والأدب، حيث تلتقي فيها ثلاثة معابر من أربعة التي يدرك الإنسان من خلالها العالم وهي (العقل والقلب والروح والجسد). ومن الملفت أن إبراز العين جاء متلازماً مع الأفعال المرتبطة بالضوء، بما يشير مجازاً إلى إيجابية الشخصية الموسومة، كما نجد ذلك في الاستعمال المتكرر لفعل “لمع” ومشتقاته.
وهنا تحضر حالة العشق التي تنعكس عبر التماع العينين، وهي أسلوبية أدبية تذكّر بمفهوم “التبلوّر-Cristallisation” الذي طرحه ستاندال حول إشعاع عيون المحب وحاله حين وقوعه في الحب.
وتظهر العينان اللامعتان في حالات أخرى حين تشعر الشخصيات بالنشوة والفرح، ولاسيّما عند تلك الشخصيات الشابة المغامرة في انخراطها بالثورة، لتصبح انفعالات العيون وسيط محاكاة لوضع البلاد، ولكن بقيت العين في معظم الروايات عضواً نبيلاً وليس كوسيط للدلالة على حالة شكّ أو ضعف أو موات، ليؤكّد أن الروائيين “قد جعلوا من الجسد، وهنا من عضو واحد من أعضائه: العين، مرآة للواقع السوري”.
الشوارب واللحى: تُعتبر الشوارب واللحى أكثر المظاهر الخارجية دلالة وترميزاً تعكس مرجعيات مختلفة ما بين دينية وسياسية واجتماعية. وفي أثر هيمنة الثقافة الإسلامية في المنطقة العربية تكتسب اللحية أهمية في تحديد الهوية الدينية للذكور المسلمين، وهنا يذكّر الباحث أنه ورغم هذه الهيمنة لا يعني أن اللحية كانت كليّة الحضور في سوريا وذلك للأسباب التالية:
– الإسلام السوري هو إسلام شديد الاعتدال.
– تشرّب الثقافة المدينية الحداثية وقيم الأناقة العصرية.
– تبني السلطات الحاكمة المتتالية نهجاً شبه علماني.
ومع ذلك يتناول التحوّلات الرمزية لظاهرة اللحية، بدءاً من التسعينيات مع تجديد الصورة النمطية للضابط السوري والشخصية العامة، بعد وفاة “باسل الأسد” النجل الأكبر لحافظ الأسد، الذي انتشرت صورته وهو في نظارات سوداء تغطي العينين مع لحية خفيفة.
وبشكل تدريجي تحوّل الشباب السوري من حليقي الوجه إلى إبقاء اللحية الخفيفة في انفصال تام عن ميولهم السياسية تجاه النظام، وهي ظاهرة يمكن تفسيرها من خلال مفهوم “الذكاء البدني-Intelleigence corporelle”، حيث “يتمّ اكتساب الخبرة واكتساب الصفة بفعل المحاكاة والتكرار”.
وتوالت تحوّلات دلالة اللحى مع نشوب الانتفاضة عام 2011، حيث أرخى الشبيحة لحاهم، كما ظهرت اللحى لدى مقاتلي الجيش الحر، التي كانت في البدايات تتبع ظروف عيشهم حيث لا وقت ولا إمكانيات للاعتناء بحاجات الجسد، وتالياً تأسلمت المعارضة وأصبحت المبالغة في إطالة اللحى لدى كافة الأطراف قاسماً مشتركاً لدى الشبيحة والموالين والمجاهدين ومقاتلي الجيش الحر واللصوص، أي فقدت الدلالة معناها الأحادي في التعبير عن الهوية وأصبحت مركّباً معقّداً من الإحالات والتأويلات، حيث “تعددت الدلالات واللحية واحدة”.
الجسد المُحَيوَن بين الأهلنة والوحشنة
لم تحضر أسلوبية الأنسنة، وهي منح كائنات لا تنتمي إلى الجنس البشري مزايا بشرية، مثلما تحضر الأسلوبية المناقضة “الحَيونة”، وهي إضفاء صفات أو سمات للشخصيات البشرية للتحول إلى الجنس الحيواني، هذا التحوّل الذي يتم من خلال آليتين أساسيتين هما المماهاة والترميز. تنقل الروايات المدروسة عملية الحيونة في اتجاهين متباينين في القيمة الرمزية التي يمثّلانها.
الاتجاه الأول: الأهلنة، وهي الصفة التي يمكن إطلاقها على الحيوانات الأليفة، وجميع الاستعارات في هذا السياق تذهب نحو الناس العاديين والضعفاء الرازحين تحت ظلم النظام ومن ثمّ الجهاديين. الاتجاه الثاني: الوحشنة، وهي الصفة التي تنتمي إلى الوحوش، حيث تذهب جميع الاستعارات نحو عناصر الأمن وعناصر الجماعات الجهادية.
ويعير الباحث اهتماماً خاصاً بتشبيه الإنسان بالكلاب “الكلبنة”، الذي يحقق الاتجاهين في المماهاة والترميز، مشيراً إلى رواية روزا ياسين حسن “الذين مسّهم السحر”، حيث بلغت استخدامات الكلبنة أربع عشرة مرة توازعت على ثلاثة أشكال:
– الكلاب السوريون الذين يعيشون حياة ذليلة أشبه بعيشة الكلاب.
– الصفة التي يطلقها الموالون للنظام على المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات.
– فعل التحقير من قبل المتظاهرين تجاه الموالين للنظام.
وفي جميع هذه الاستخدامات تظهر الرمزية الأخلاقية الدونية للكلاب، ما يمثّل المخزون الثقافي المشترك لجميع هؤلاء الروائيين.
الجسد الميت من القدسية نحو الابتذال
ينوّه عبّاس أنه بالكاد تخلو رواية من مشاهد الموت والقتل وكأن الرواية السورية مقبرة جماعية، إذ يتحوّل حضور الموت في الحرب، من حدث استثنائي في الحياة العادية الطبيعية ليصبح أحد تفاصيل الحياة اليومية العابرة، وأحياناً يصبح أمراً مشتهى في سبيل الخلاص من جحيم الحرب، وتحت هذا الواقع اللاواقعي، “يتحوّل حضور الجثث في الروايات من عنصر استثنائي الأهمية تنبني عليه الحكاية أو تعوّل عليه كذريعة لاستمرارية السرد أو كمتكئ تستند إليه لتنعطف نحو مسارات جديدة إلى حضور مبتذل، تافه، مفرّغ من أي أهمية”.
ويمكن رصد هذا التحوّل من الغرابة إلى المبتذل عبر الانتقال من الحالة الطبيعية للبشر عند تأثّرهم بمشاهد الموت القتل إلى حالة التعوّد على شيء استثنائي لم يكن باعتبارهم طبيعياً من قبل، وهو ما ساهمت به أيضاً الوسائط الإعلامية في نقل الحدث، فيصبح مجرّداً من فرادة الحكاية التراجيدية، ويغرق في مستنقع العادي المبتذل.
ويطلق الباحث مفهوم “التجثث” على مشهدية تحوّل الجسد إلى جثة، “بما يشبه اللقطة السينمائية التي يطيل خلالها الراوي النظر إلى تفاصيل الحدث ليعيده بأقرب ما يمكن من الواقعية”.
وهنا تحضر رواية خالد خليفة “الموت عمل شاق” كمحور أساسي، كون الجسد في الرواية هو موضوعها وحكايتها، حيث ترمز تحولات الجثة من النضارة إلى التفسّخ والتي تمّ رصدها في سبع لقطات في ترميز دلالي لتحوّل البلد، من الحالة الطبيعية بما فيها من فساد وبيروقراطية إلى التفتت الكلي الذي يهدد بالفناء الكامل.
الجسد وقوته الرمزية
تشير الملاحظات والنتائج التي خرج بها الباحث، أن الحرب تخلق ملامح ثقافية جديدة حول الجسد، وهي ثقافة ابتذال الجسد كونها تنزع الحرم عنه، كما شكّلت الفلسفة العدمية خلفية رؤيوية، تعامل الروائيون من خلالها مع الجسد الذي يحضر بقوة في روايات الحرب كجسد منتهك، تمثّلا بحال البلد وما آلت إليه أوضاع السوريين، وهنا يكتسب الجسد قوة ترميزية ليصبح رمزاً لكل سوريا.
ورغم سوداوية الرؤية، تثير جميع هذه النقاط تلميحاً للبحث عن تمثّلات جسدية أخرى تمّ إغفالها أو إرجاءها إلى مناسبة أخرى كما أشار الباحث إلى ذلك، مثل المثيرات الحسيّة والجنسانية، وبما أن هذه الفرصة لن تأتي مع عبّاس، فقد كان كريماً في وضع وصيته البحثية هذه، عسى أن تغدو صورة الجسد أقل مأساوية بما يسمح الواقع الذي يتمثّله.
رصيف 22