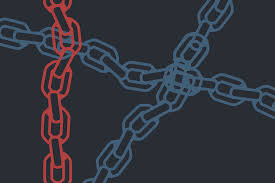عن العنف وصعوبة السياسة/ راتب شعبو

تكمن صعوبة السياسة، ولا سيّما السياسة المعارضة أو التغييرية، في أنّ تأثيرها يتوقف على نجاحها في إقناع الناس، الشيء الذي لا ينطبق على أوجه النشاطات البشرية العامة الأخرى؛ إذ لا يتوقف نجاح الشاعر أو الكاتب أو العالم على إقناع الناس، فقيمة إنتاج هؤلاء لا تتوقف على عدد مَن يقتنع بهم، بل على إبداعهم وجودة إنتاجهم. يمكن لشاعر أن يقول إنه يكتب للأجيال القادمة، وقد يتأخر الاعتراف بقيمة شاعر قرونًا من الزمن، لكن الزمن لا يحفظ قيمة السياسي الذي لم يُحقّق فعلًا سياسيًا في زمنه؛ فلا قيمة للسياسي إلا في زمنه، لأن قيمة نشاط السياسي تتوقف على اقتناع الناس باقتراحاته وبمشروعه، ومن ثَمّ على قدرته على حشد الناس والتأثير في اللحظة الراهنة.
صحيح أن الزمن يمكن أن يحفظ قيمة مقترحات أو أفكار سياسية معينة، لكن هذا يقع في دائرة الفكر السياسي وتاريخه، لا في دائرة الفعل السياسي الذي نقصده هنا، والذي هو المجال المباشر لعمل السياسيين.
على هذا؛ فإن للسياسي مهمّة من طابقين: ابتكار المقترح، وإقناع الجمهور به. وعلى الرغم من أهميّة التوصل إلى مقترحات أو مشاريع سياسية مناسبة، يبقى العبور إلى إقناع الجمهور، ومن ثَمّ إلى التأثير السياسي، محفوفًا بعوامل الإحباط. فعلى بوابة الاقتناع، يقف حرّاس من طبيعة معرفية (الجهل)، وحرّاس من طبيعة نفسية (التشكيك وانعدام الثقة بالنخبة) أيضًا. وقد يقف هؤلاء الحرّاس في وجه أفضل الأفكار، ويحيلونها إلى عدم، وقد يسمحون لأسوأ الأفكار بالعبور الآمن والتحكم في سلوك الناس وانحيازاتهم العامة!
هذا الحال يغري السياسي بالتخلي عن مهمة التفكير في جودة المقترح السياسي والاهتمام بإرضاء “الحراس”، فيتغلب السعي إلى كسب الجمهور على السعي إلى تقديم مشاريع أو مقترحات وأفكار سياسية مفيدة. إثارة المخاوف، مثلًا، أو الوعود الإنشائية الكبيرة من طراز “زمن التغيير” أو “لنجعل أميركا عزيمة مجددًا” أو “السيادة الوطنية”… إلخ. وهذا ما يشكل أحد تفسيرات بروز الشعبوية. ذلك أن فاعليتك كسياسي لا تقاس بمنطقية أو جودة أفكارك، بل بقدرتك على حشد الناس.
هذا في البلدان التي تحتكم إلى آليات سلمية في التأثير السياسي الداخلي. في بلادنا، يتخذ الأمر بُعدًا جديدًا يتصل بالحضور الدائم للعنف. هنا يدخل العنف على المعادلة، بوصفه عنصرًا حاسمًا يؤثر مباشرة في “إقناع” الجمهور. الحضور الطاغي للعنف يُريح السياسي من مهمة الإقناع وكسب الجمهور، وهي المهمة الأكثر وعورة. لا ينطبق هذا على السلطات الحاكمة فحسب، فقد كان العنف عنصرًا أساسيًا دائمًا في يدِ السلطة الحاكمة “لإقناع” الناس، بل ينطبق أيضًا على المعارضين الساعين إلى التغيير.
تحدي السلطات العنيفة بالعنف يمتلك جاذبية خاصة قادرة على أن “تقنع” الجمهور. مستوى القهر المتراكم لدى الجمهور المحكوم طويلًا لسلطات مستبدة، يجعل للعنف المضاد قدرة على جذب الجمهور مستقلة عمّا يريده هؤلاء المعارضون العنيفون. هكذا يستقل العنف عن السياسة، يصبح العنف سياسة ذاته، ويصبح له من التأثير الفعلي على قلوب الجمهور ما يمكنه من تغطية الانحطاط السياسي لأصحابه. الإنتاج العنفي لـ “الطليعة المقاتلة” في سورية، نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، هو من خلق جمهورها، وليس إنتاجها السياسي الذي كان شبه معدوم.
المواجهة العنيفة تسير إلى هزيمة عسكرية تامة لأحد الطرفين (السلطة القائمة أو معارضيها العسكريين)، أو إلى تسوية تحيل المعارضة المسلحة إلى جزء من السلطة، أو إلى أن تفرض المعارضة المسلحة سيطرتها على مجال جغرافي معين، ومن ثمّ تتحول إلى سلطة “تقنع” جمهورها بالعنف. في كل هذه المسارات، تكون السياسة ضامرة أمام العنف. ضمور السياسة يعني تلقائيًا تتبيع الجمهور أو تهميش ثقله.
يمكن القول إن التغيير العنيف هو ممر إجباري في مجتمعات تستبد بها سلطات عنيفة متأصلة في بنية المجتمع، لكن يبقى صحيحًا القول إن حضور العنف في المعادلة، وإن كان قادرًا على إحداث تغييرات في السيطرة، يشلّ التطور السياسي، لأنه يُحِل الخوف بدلًا من التفكير والاختيار الحر، ولأنه يهمّش الجمهور ويحيلهم إلى أتباع أو شاهدين على حرب، ويحصر الفاعلية في يد النخب العسكرية التي من طبيعتها أن تحتقر السياسة التي تعني إدارة الصراعات، بحسب التوازنات الداخلية السياسية وليس العسكرية. فضلًا عن أن العنف يعلي من شأن الهويات بدلًا من الأفكار، ومن شأن السيطرة بدلًا من الشراكة، ويعبّئ المجتمع بطاقة انفجار دائمة اسمها “رغبة الانتقام المتبادلة”.
حتى لو افترضنا أنّ النخبة المعارضة التي تجد نفسها مجبرة على توسل العنف، كي تواجه استبداد السلطة، هي نخبة تؤمن بالشراكة ولا تريد احتكار السلطة، وتريد التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان … إلخ، فهل تستطيع هذه النخبة أن تحافظ على “ديمقراطيتها” في سياق الصراع العنيف الذي يتطلب الطاعة والمركزية والحسم ومنع الاختراقات وتعزيز مبدأ العصبوية… إلخ؟ من طبيعة الأشياء أن يفرض المنطق العسكري نفسه على كل منطق آخر، سواء في سياق الصراع أو في حال تمكنت القوة العسكرية من السيطرة على بقعة من الأرض محاطة بقوى عسكرية معادية قديمة أو مستجدة.
الصراع العنيف الذي تلا الثورة السورية أنتج، في استقراره المؤقت، سلطات من طبيعة متشابهة، ولا يمكن، بناء على شروط نشأتها ووجودها، أن تكون غير متشابهة في علاقتها مع الجمهور في منطقتها. وعلى هذا؛ لا يمكن أن يقوم الصراع بين هذه القوى إلا على عصبيات هوياتية، لا على أفضليات سياسية عامة.
صعوبة السياسة في مجتمعنا تأتي إذن من أمرَين: الأول هو صعوبة إقناع الجمهور، وهذه صعوبة عامة نشترك فيها مع المجتمعات ذات أنظمة الحكم الديمقراطية؛ والثاني -وهو يخصّ مجتمعاتنا أكثر- هو حضور العنف بوصفه وسيلة “الإقناع” الأشد فاعلية. إذا ما تقدّمنا خطوةً في السياسة أو في البحث عن خيارات تطوير حياة سليمة وسلمية مشتركة، فإن العنف يعيدنا خطوات إلى الخلف، ويحقن النفوس بنزعات السيطرة والانتقام ذي الطابع الهوياتي المضاد للسياسة.
مركز حرمون