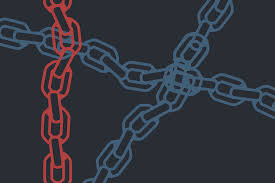مادة الحلّ النهائي .. السوري العادي ومقدمات عملية/ مضر رياض الدبس

طرحَ الكاتب فكرة “الحلّ النهائي” في مقالة سابقة “المسألة السورية وتأسيس الحلّ النهائي” (العربي الجديد، 31 يوليو/ تموز 2021)، ثم استكمل فكرة تأسيس الحل النهائي في مقالتين متممتين “سبعة معانٍ للتفكير بعد 2011″ (العربي الجديد، 6 أغسطس/ آب 2021)، و”التأويلات الكارثية للثورة السورية” (العربي الجديد، 21 أغسطس 2021)، واستكمالًا لهذا المسار في التفكير نحو تحديد خطوات عملية للحل النهائي، تطرح هذه المقالة إلى النقاش العمومي السوري فكرةً ثانية، نسميها “مادة الحل النهائي” وتحاول بسط هذه الفكرة، لكن بعد استذكارٍ سريعٍ وضروري لأهم الأفكار التي رأى الكاتب أنها تؤسس للحل النهائي، ويمكن تكثيفها في النقاط الآتية:
أولا، فهمٌ جديدٌ لطبيعة الصراع في سورية: ليس الصراع بين معارضة ونظام، أو بين نظام وشعب، لكنَّه صراعٌ بين منظومتين ذهنيتين، عصرية تنتمي إلى ما بعد 2011 تمتلكها كائنات زمانية، ومنظومة ذهنية تنتمي إلى ما قبل 2011 وتمتلكها كائناتٌ لم تنجز العبور إلى ما بعد 2011.
ثانيا، اختار السوريون الدخول من باب “العمومي”، وأدخلت الثورة مفهوم العمومية إلى السياسة السورية التي كانت قبلها باطنية؛ فتغير الخطاب الذي يقاوم النظام من عقلية المعارضة النخبوية الضيقة الضعيفة إلى الذهنية العمومية المفتوحة القوية التي يشارك فيها الكل. وكانت الثورة فعلا عقلانيا في جوهره، تم تأويله تأويلاتٍ كارثية (ناقشها مقال سابق).
ثالثا، مضمون خطاب الثورة كان نقيضًا للنظام والمعارضة معًا، لأنه صار مفيدًا يستند إلى فكرةٍ جوهرها أن السوري أصبح ذاتًا مُفكِّرة، بعد أن كان موضوع تفكيرٍ مُفكَّرًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم أو من “معارضةٍ نخبوية”.
رابعا، ينطلق الخطاب الوطني من التوق إلى الحياة الذي يتشاركه السوريون كلهم، وهذا التوق إلى الحياة هو المشترك الأكثر وضوحًا في الخطابات العفوية المختلفة، مثل خطاب الموالاة (كنا عايشين)، وخطاب الثوار المنهكين (بدنا نِخلَص)، وخطاب الـ”ما بين” (بدنا نعيش). وخطاب الحياة نقيضُ خطاب الحرب والكراهية وخطابات القتل، سواء قتل الآخر أو قتل الذات بخطابات التضحية والاستشهاد والجهاد وغيرها. وهو خطابٌ متحرّرٌ من خطاب النظام بطبيعة الحال، ومن خطاب المعارضة بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار المعارضة ويصنع سلطة تحريرٍ وطنيةٍ شاملة، لا تقيم وزنًا لطقوس المعارضة السياسية.
ونفهم الثورة بموجب هذا التأسيس بوصفها فعلًا تواصليًا، ومشروعًا تنسيقيًا ممتدًا، وهذه الخاصية التواصلية هي التي ميَّزت السوري الجديد بعد 2011. ولم يمتد هذا التواصل إلى من يشبه المبادرين إليه، ومن يشاركهم الرأي والمعتقد فحسب، بل كان عابرًا للحدود كلها، بما فيها حدود “العدو” القاتل؛ فتمَّ التواصل مع الجنود بالورود، وبكثير من الخطابات التي بنيت على الحب، وتحفيز الإنسان فيهم. ولأن المنهج التواصلي كان جديدًا، غير نخبوي، صار نتاجه (أي الثورة) موضع تأويلٍ وسوء فهمٍ دائمين.
واستنادًا إلى هذا التأسيس، صار بإمكاننا الانتقال إلى سؤالٍ آخر لا يقل أهميةً عن تأسيس الحل، وهو عن مادة هذا الحل، أو عن الأداة الأكثر ملاءمةً لإنجاز هذا الحل. ويبدو، بعد التفكير على أكثر من مستوى، أن المشهد ذاته الذي نتجت منه المسألة السورية لا يزال أيضًا مفتاح حلها، ويعني ذلك شيئًا مهمًا: إن السوري العادي الذي كان مادة الثورة السورية قبل عشر سنوات لا يزال مادة حل المسألة السورية النهائي اليوم. و”السوري العادي” (Layman) توصيفٌ يتطابق مع توصيف “ثائر ينتمي إلى ما بعد 2011″، لأن الثورة هي مشروع السوريين العاديين التواصلي الكبير الذي انطلق من دون النخب، بأنواعها الثقافية والدينية والاجتماعية، وإلى ما هنالك. ومن سمات السوري العادي أنه إسلامي، لأنه جزء من الثقافة السورية الإسلامية مع إمكانية أن يكون غير مسلم أو غير مؤمن، وأنه علماني لأنه مفصولٌ عن المؤسسة الدينية مع إمكانية أن يكون مؤمنًا… والسوري العادي متديّن، وملحد، وديني، ولا ديني، وينتمي إلى ثقافة قبلية عشائرية، أو مديني لا عشيرة له، غني أو فقير، عربي وكردي وأرمني وآشوري وشركسي، إلى ما هنالك… السوري العادي هو جمعٌ سلس لهذا كله من دون تناقض؛ لأنه فردٌ متحرّر من سطوة الجماعة أيًا كانت. هكذا نستطيع أن ننحت تعريفًا أدقّ للثورة السورية؛ فنقول: الثورة هي تنسيقيةُ السوريين العاديين الكُبرى، التي أدّت إلى خروجهم بوصفهم أفرادًا يتوقون إلى ذواتهم، في تظاهرة واحدة، راكموا فيها رأس مال اجتماعياً سورياً؛ فعادوا منها جماعةً وطنية مدينية، وصاروا بموجبها يقتربون من فردانيتهم أكثر، ومن ثم يقتربون من ذواتهم أكثر. وبموجب رأس المال الاجتماعي الوطني هذا، صار السوري العادي، لأول مرةٍ في حياته، مؤهلًا للعمومي، وصارت سورية لأول مرة فكرةً ممكنةً بالمعنى السياسي والاجتماعي، وصارَ هذا الإمكان ذا قيمةٍ تحيل على الكرامة.
وإذا استندنا إلى تعريف الثورة هذا، وقبلنا بعلاقتها العضوية مع السوري العادي، يصير بإمكاننا أن نضع مقدّماتٍ للخطوات العملية نحو الحل، أو مداخل عريضة للإجابة عن سؤال ما العمل. ويمكن أن نبنيها كالآتي:
أولًا: أن نضع الحياة الكريمة وصونها بوصفها هدفًا غائيًا وخلفيةً ذهنيةً ومنهجيةً لكل هدفٍ استراتيجي، من ثم مناهضة كل خطابٍ يدعو إلى القتل، أو إلى التضحية بالنفس، أو إلى أي فعلٍ يحتفي بالموت. وتصنيف أعداء الحياة كلهم بوصفهم أعداءَ السوريين.
ثانيًا: العودة إلى الطريق الأول، الذي يعني طلاقًا كاملًا بين السوري العادي والنخبة التي تنتمي إلى ما قبل 2011. يعني هذا الطلاق، بطبيعة الحال، توقفًا كاملًا عن استهلاك منتجات هذه النخبة وصناعاتها، مثل الطائفية، والمناطقية، ومفهومي الأقليات والأكثرية، والتعصّب الإثني، والأيديولوجيات؛ فهذه جميعها من صناعة النخب، وليست من صناعة السوري العادي.
ثالثًا: تحفيز التفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011، وبسط أفكاره وفوائده، وبناء خطاب عصري يستند إليه للوصول السلس إلى ما يسميه هابرماس “مخزون النقد الذي تتم مراكمته في صلب الفعل التواصلي”؛ فالثورة بوصفها فعلًا تواصليًا تُنتج أيضًا مراقبةً ذاتيةً لمسار التفاهم الذي يتطوّر باستمرارٍ في جوهرها.
رابعًا: العودة إلى الثقة السورية الكلاسيكية المتجذّرة في المجتمعات المحلية السورية، والارتقاء بها خطابيًا إلى المستوى السياسي، لاستثمارها في زيادة مراكمة رأس مال اجتماعي وطني. واستثمارها في أنظمةٍ أكثر ملاءمة للزمان وللمشروع الوطني، مثل اللامركزية الواسعة، والغيرية أو “المواطنوية” (civility).
خامسًا: تمثيل السوريين في عالم السياسة، وتمثيل السياسة في عالم البسطاء، وهذا يتطلب بناء سياسياً سورياً يُترجِم من العمومية وإليها: يبني خطابًا من كلام السوري العادي، ويفكّك الخطابات للسوري العادي، وهذه هي نواة النخبة التي تنتمي إلى ما بعد 2011، هي نواة من “المترجمين من العمومية وإليها”. وبناء هذه النواة، في واحدٍ من أهم معانيه، هو انقلابٌ أبيض على السياسيين السوريين الكاذبين، وعلى السياسيين الصادقين ولكن غير الأصيلين: الذين يفتقرون إلى الأصالة اللازمة لنقل المشهد (ترجمته) بدقة؛ فتصيرُ صدقيتهم شيئًا نظريًا لا يعمل. الأصالة والصدقية متداخلان يستحيل فصلهما، إذا كان الكلام عن السياسي المؤهل للعمل في الحلّ التنفيذي للمسألة السورية؛ فادّعاء الأصالة من دون إنجاز صدقية ملائمة كاذب، وادعاء الصدقية من دون الاستناد إلى أصالةٍ تبنيها واهم. لذلك لا يكفي أن يكون المرء صادقًا ليكون مترجمًا من العمومية وإليها (أي ليصير مؤهلًا للعمل السياسي السوري)؛ لكن يجب أن يكون أصيلًا أيضًا: الصدق والأصالة معًا هما شرطا السياسي السوري، ليكون مؤهلًا ومقبولًا للعمل، والانقلاب الثوري على كل من لا يتمتع بهما بالدلائل التجريبية منذ 2011 فعلٌ مشروعٌ، يصب في حق السوري في حماية نفسه من النظام والمعارضة معًا.
سادسًا: استخلاص مفهومات الاجتماع السياسي من صلب عالم الحياة الخاص بالسوري العادي الذي ينتمي إلى ما بعد 2011. هذا يعني تأويلًا عقلانيًا للثورة من الذين لم يشاركوا في خلقها، وهذا بطبيعة الحال تفكير نيته الفهم والتعليل، ولأن التعليل والتعلُّم مفهومان مترابطان على أكثر من مستوى، يصير هذا التأويل العقلاني مهمًا جدًا.
العربي الجديد
———————————
المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي/ مضر رياض الدبس
تتغيّر طرائق حلول المشكلات بتغير طرائق فهمنا هذه المشكلات. لذلك يمكن القول إن التقدّم في ابتكار حلول ناجعة للمشكلة السورية مرتبط بفهمٍ أدق لجوهر هذه المشكلة، ومن ثم بتصورٍ جديد لها، ولحلولها بطبيعة الحال: أي إنه مرتبطٌ بفهمٍ ومفهومية معاصريْن، يؤديان إلى تغيير مقارباتنا لجوهر المشكلة وممكنات الحل. والفهم الذي نقصده ليس على مستوى آليات السياسة وطرائق العمل والتنظيم، مع أنه مهم، بل على مستوى إعادة فهم جوهر الصراع وطبيعة المشكلة السياسية، لأن غياب فهمٍ دقيق على هذا المستوى يؤدّي إلى غياب الأهلية اللازمة للحل. وتطرح هذه المقالة، في هذا السياق، أن المقابلة الجوهرية ليست بين منظومة الطغمة الحاكمة التي قامت الثورة ضدها، ومعارضة سياسية أو عسكرية ساندت الثورة، بل بين منظومةٍ قبليةٍ عصبيةٍ أيديولوجيةٍ يتحكم فيها نمط تفكير ينتمي إلى ما قبل 2011، وتضم النظام والمعارضة معًا، ونمط مديني يحكمه تفكير عصري ينتمي إلى ما بعد الـ 2011. وهنا نحن نتحدّى صلاحية الثنائية (نظام، معارضة)، ونطرح زيفها بوصفها تفكيرًا غير واقعي، لم ينظر إلى مفاعيل الزمن المتسارعة. وتصير المعارضة، من هذا المنظور، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة، مع أن الفرق الأخلاقي شاسعٌ بين الاثنين، فمهما تحفّظ المرء على أداء المعارضة وماهيتها، لن يصل إلى مساواتها أخلاقيًا بالطغمة الحاكمة التي تجاوزت سفالتها أكثرَ خيالاتنا بشاعةً وتشاؤما؛ ففي التصنيف الأخلاقي، ومن دون شك، لا يمكن جمع الاثنين، ولكن في التصنيف السياسي الذي ينظر إلى الأمور من جوهرها ينتمي الاثنان إلى ما قبل الـ 2011، وإلى زمان ما قبل العمومي السوري…
ولكي نعرف أكثر بعض ما يعنيه ذلك، نحكي الحكاية السورية من بدايتها بطريقة ثانية كالآتي:
تنامى إحساس السوري بحاجته إلى إعادة ملكية وطنه (سورية لينا وما هي لبيت الأسد)، واسترداد كرامته (الشعب السوري ما بينذلّ). ولتلبية هذه الحاجة، دخل من بابٍ جديد هو باب “العمومي”، والعمومي غير العام، وهو ليس رفضًا لخصخصة الوطن التي فرضها النظام فحسب، وليس تكوين رأي عام فحسب، بل يتعدّى العمومي ذلك كله إلى مجموعة النقاشات العلنية والمفتوحة والحرّة، والتي تعترف بكل فردٍ وبكل ثقافةٍ وبكل جماعة، ولا تلغي أو تقصي أحدا. وعلانية هذه النقاشات هي بالتحديد ما يكسبها صفة العمومية. وتخلق العمومية فضاءً غير منتهٍ يتسع للجميع، اسمه “الفضاء العمومي”. وبهذا المعنى، صار الشعب السوري كله مؤهلًا للعمومي مع ثورة 2011. ولا يتواصل البشر في الفضاء العمومي بالكلام أو بالحديث أو بالأخبار، بل يتواصلون بالخطابات. والخطاب، بهذا المعنى، جزءٌ من التصور البنائي للمجتمع السوري، وهو وحداتٌ تواصليةٌ مضمنة في الممارسات الاجتماعية والثقافية والسياسية. وكما كوّنت الثورة خطابا، فإن الخطاب كوَّن الثورة أيضًا، والخطاب بالضرورة أحال الثورة على مفهوم السلطة، بما فيه من فعلٍ في الأفعال، فهو أداةٌ من أدوات السلطة، يبني سلطةً ويلغي أخرى، وهو سلطةٌ بذاته. هكذا نقول إن الثورة أضافت إلى الباراديغم (النموذج) السياسي السوري خطابًا غير خطاب النظام، وأيضًا غيَّرت في خطاب النظام؛ فبعد أن كان لدينا قبل 2011 خطابٌ أوحد، يقوم على تسخيفٍ ممنهج للحياة، ويتسم بالشعبوية والتوليتارية، حاولت مواجهتَه معارضةٌ هزيلةٌ بعقل توصيفي حالم، لم يصنع خطابًا ناجزًا، وظل حبيس حدود “حيزٍ نخبوي” لم ينطلق إلى العمومي، أو لم يتمكّن من ذلك؛ صار لدينا بعد الـ 2011 خطابان: خطاب النظام الذي صار “معي أو ضدي” و”أنا أو لا شيء”، وخطاب الثورة التي أدخلت العمومية إلى السياسة السورية الباطنية؛ فتغير الخطاب الذي يقاوم النظام من عقلية المعارضة النخبوية الضيقة الضعيفة إلى الذهنية العمومية المفتوحة، القوية التي يشارك فيها الكل. وتغير مكان الخطاب من أماكن مغلقة محدودة، مثل المنتديات وبيوت المعارضين، إلى مكان مفتوح في الشوارع والساحات. ولم تتمكّن المعارضة السياسة التقليدية من التقاط هذا التغيير ومواكبته، وتطوير نفسها بموجبه، لكنها ظلت نخبةً متعالية. ولذلك يمكن أن نقول اليوم إن مضمون خطاب الثورة في العمق كان نقيضًا للنظام والمعارضة معًا، لأنه صار مضمونًا مفيدًا يستند إلى فكرةٍ جوهرُها أن السوري أصبح ذاتًا مُفكِّرة بعد أن كان موضوع تفكيرٍ مُفكَّرًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم أو من معارضةٍ نخبوية.
هكذا تكوَّن بعد 2011 سوري جديد، هو الذات وهو الموضوع في الوقت نفسه، وهذه أهم ميزات هذه اللحظة التاريخية: فيها كانت الوطنية السورية لأول مرةٍ تفكر في ذاتها من دون أوصياء عليها. ولذلك نقول إن الثورة كانت ضد ذهنية الوصاية التي تضم النظام والمعارضة معًا، وثورةً عليهما معًا، ولكن الجانب الأخلاقي هو الذي جعلها تبدو كأنها ثورةٌ على النظام فحسب، فلا شيء في هذه الدنيا ينافس النظام في سفالة أخلاقه. يمكن الآن أن نتأمل كم كان، ولا يزال، تمثيلُ المعارضة الثورةِ سياسيًا فعلًا منافيا للمنطق السليم، وسببًا لغياب الحل وترسيخ بديهيةٍ كانت تحتاج مساءلةٍ لم تتم، وهي بديهية النظر إلى الصراع السياسي بوصفه بين نظامٍ ومعارضة، فيما الحقيقة إنه صراعٌ بين ذهنية تنتمي إلى قبل 2011 وأخرى تنتمي إلى بعدها. وإنها لسخرية فاحشة أن يكون من يفكّر بعد 2011 خارج السياسة السورية، وأن تكون الثنائية (نظام، معارضة) هي السائدة. وأدعو كل المشكّكين بهذه المقاربة إلى الالتفات إلى سمعة المعارضة بين السوريين منذ اللحظات الأولى للثورة، وتعليلها خارج الأفق التقليدي الذي يردها إلى تضخم الحريات.
من هذه الأرضية، يمكن أن ننطلق في التفكير في سؤال ما العمل، ولنفكّر في المسألة كالآتي: ماذا لو عدنا إلى فرض سلطةٍ تشبه في روحها سلطة 2011، بوساطة التواصل بالخطاب، بهدف ابتكار خطاب جامع، يفرض سلطة تواصلية سورية يتشاركها الجميع، ومنها يستمد السوريون كرامتهم، سلطة قادرة على إنهاء إمكانية فرض أي أنموذج مسبق على السوريين، وإنهاء الحواجز المكانية بين السوريين التي عمل على ترسيخها النظام، واستمات في تقويتها، مثل داخل/ خارج، مدينة/ ريف، شرق الفرات/ غرب الفرات، إلى ما هنالك. من دون شك، ستبدأ هذه السلطة التواصلية بالعمل لمصلحة السوريين وأهداف ثورتهم من اللحظة الأولى، ولكن كيف ستتكون؟ هذا سؤال سياسي، له إجاباتٌ على أكثر من مستوى، ولكن أكثرها أهميةً هو المستوى المفهومي، الذي يبدأ بتصوّر الخطاب الوطني الجامع، فالخطاب يمتلك قوة هائلة في هذا الزمن السوري المعاصر لبناء سلطةٍ سوريةٍ إيجابية تفرض نفسها على النظام، وعلى العالم كله. وفي سياق تصوّر هذا الخطاب، ننطلق من التوق إلى الحياة الذي يتشاركه السوريون كلهم، ويمكن تتبعه في الخطابات العفوية المختلفة، مثل خطاب الموالاة (كنا عايشين)، وخطاب الثوار المنهكين (بدنا نِخلَص)، وخطاب الـ “ما بين” (بدنا نعيش). تشترك هذه الخطابات وغيرها في إرادة حياة واضحة، يمكن أن تكون منطلقًا في بناء الخطاب الجامع، بحيث يستفز إرادة الحياة الخيرة والآمنة لدى السوريين، وهي إرادة تمرّ بالآخر بالضرورة؛ فتصنع جماعة مدينية تراكم لنفسها رأس مال اجتماعي وطني. خطاب الحياة وطني، ونقيضٌ لخطاب الحرب والكراهية وخطابات القتل، سواء قتل الآخر أو قتل الذات بخطابات التضحية والاستشهاد والجهاد وغيرها. وهو خطابٌ متحرّرٌ من خطاب النظام بطبيعة الحال، ومن خطاب المعارضة بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار المعارضة، ويصنع سلطة تحريرٍ وطنية شاملة، لا تقيم وزنًا لطقوس المعارضة السياسية التي بموجبها صار خطاب شباب التنسيقيات مثلًا خطابا رديئا برأي بعض المعارضين، وكأن الرداءة هي تجاوز الطقوسٍ المسبقة الجامدة! الطقوس نفسها التي تجعل من معارضٍ معتدٍّ بذاته يستنتج بفوقية أن “سورية لا تمتلك سياسيين جيدين!”. بصورة عامة، سلوك المعارضة مذهبي، والمذهبية نقيض الخطاب الوطني العمومي الذي يستهدف الحياة ويمر بالآخر بوساطة الفهم والتفاهم، والمعارضة النخبوية السورية التقليدية كانت ولا تزال مذهبًا هشًا، لا يرتقي إلى تكوين هذا النوع من الخطابات الكونية في ظروف استثنائية.
وأخيرًا، من لا يفكر في الخطاب التواصلي الذي يستند إلى حب الحياة والمغايرة والحضور الدائم للآخر ما زال كائنًا غير زماني يفكر قبل 2011، أو كائنًا لا يُفكر. والتفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011 هو الذي يوحّدنا في مشروع تحرّري وطني تواصلي، يتجاوز النظام والمعارضة معًا، ويبني لنا سلطةً لامتلاك مشكلاتنا وتحقيق كرامتنا، وهذا هو حل المسألة السورية النهائي والوحيد.
————————
سورية: سبعة معانٍ للتفكير بعد 2011/ مضر رياض الدبس
انتهى نص الكاتب بعنوان “المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي” (“العربي الجديد”، 31/07/2021) إلى أن التفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011 هو الذي يؤسّس للحل النهائي في سورية، وهو الذي يوحدنا في مشروع تحرّري وطني تواصلي، يتجاوز النظام والمعارضة معًا، ويبني لنا سلطةً لامتلاك مشكلاتنا وتحقيق كرامتنا. ولاستكمال هذه المقاربة يناقش هذا النص بعض معاني التفكير بعد 2011.
يعني التفكير حوارًا مع الذات لإنتاج معنى، وإثارةَ تساؤلاتٍ وابتكارَ طرائق تؤدّي إلى معنى. ويعني، في الوقت نفسه، إنتاجَ وعي وضمير؛ فالتفكير فعلٌ مزدوجٌ مرتبطٌ بالزمان: فهمٌ أفضلُ للموضوعات، وتأهيلٌ أكثر للذات. يؤدّي التأهيل إلى فهمٍ أدقّ وأعمق، ويؤدّي الفهم الدقيق إلى تأهيلٍ أكثر، وهكذا تستمر العملية ما دام التفكير مستمرًا. ويؤدّي تأهيل الذات المستمر هذا إلى الوعي الذي يتطابق دلاليًا مع الضمير؛ فيصير التفكير إنتاجًا مستمرًا للضمير. وللتفكير بعدٌ ثالثٌ هو الزمان، فلكل زمانٍ موضوعاته وأدواته ونمطٌ لمنهجياته وأولوياته، وله نطاقُ تفكيرٍ مركزي خاص به، ونطاقاتٌ ثانوية في محيطيه. ولكل زمانٍ أنماطه (بارادايماته)، وليس التحول النمطي (paradigm shift) إلا تغيرًا في الزمان يستتبع تغيرًا في مناويل التفكير على مستوى اختيار موضوعات التفكير ومشكلاته: كيفية طرحها، وكيفية حلها. وبموجب ذلك، يمكن أن نقول إن لحظة 2011 هي لحظة التحوّل النمطي إلى العمومي التي طرحت مشكلات غياب الحرية والكرامة والعدالة، بوصفها أولويات الحياة، وأرادت حلها بإسقاط العقبة الأولى التي تحول دون ذلك، وهي النظام الحاكم، فدخلت إلى أهدافها من باب الحراك العمومي. أي إن الثورة وضعت فكرة الحياة الحرّة التي تمرّ بالعمومية الوطنية، نطاقًا مركزيًا جديدًا في التفكير؛ فصار ما بعد 2011 زمانًا سوريًا جديدًا يجُب ما قبله. والثورة، بهذا المعنى، كانت ثورةً على ذهنية ومنظومة متكاملة، يمكن تسميتها ذهنية ما قبل 2011، وتضم النظام والمعارضة وكثيرَ الأنماط الاجتماعية والسياسية التقليدية؛ فما معنى أن نفكر بعد 2011؟
أولًا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نفكّر عموميًا، أي أن نفكّر في الضوء دائمًا، بصورةٍ علانية وواضحة وجريئة وشجاعة. وكل تفكيرٍ سرّي أو باطني هو تفكيرٌ ينتمي إلى ما قبل 2011؛ فالشرطة السرّية، والمُخبر الأمني، والأقبية، والتلون، و”الحربقة”، واللف والدوران، والمنشورات السرية، كلها أفكار تنتمي إلى سياسة ما قبل 2011؛ وأيضًا الطقوس الدينية السرية، والمذاهب الباطنية، والتقية، والجماعات المتكوّرة على ذاتها، وفكرة القومية، والمظلومية، كلها ممارسات اجتماعية تنتمي إلى ما قبل 2011، إلى زمان ما قبل العمومي السوري. والعمومي السوري لصيق بالعلانية، والعدالة، والمساواة، وجبر الضرر وتعويضه، والتوزيع العادل للثروة، والاجتماع السلمي الذي يستند إلى أسسٍ مدينية. وفي الضوء فحسب، يكون التفكير عموميًا، وفعلًا وطنيًا أصيلا. وكل تفكيرٍ في السياسة، وفي الاجتماع السياسي، يستند إلى أسس فوق وطنية (مثل الأمة العربية، والأمة الإسلامية، والأممية البروليتارية)، أو تحت وطنية (مثل المذهبية، القبلية، الطائفية، العشائرية، المناطقية)، هو تفكيرٌ لم يعبر به الزمن إلى ما بعد 2011، وظل قابعًا في ما قبلها في أحسن الأحوال، إن لم يكن ثاويًا في أعماق التاريخ البعيد قبلها بعقودٍ وقرون. والثورة السورية، بهذا المعنى، نعمةٌ كبيرةٌ وفضلٌ من الشعب لمن كان قبلها من الموجودين حيويًا من دون أن يعيش، لأنها أعادت إلى هؤلاء كلهم الزمانَ المسلوب من تفكيرهم ومن وجودهم، وأعادتهم إلى الزمان؛ فالإنسان يعيش في زمانٍ، إن فقده يحيا ويموت من دون أن يعيش. لذلك من يقول “كنا عايشين” يتوّهم ويفكر قبل 2011، ومن يقول “بدنا نعيش” عليه أن يعبر إلى ما بعد 2011 ليصير كائنًا زمانيًا مؤهلًا للعيش، وغير مكتفٍ بالبيولوجيا.
ثانيًا: أن نفكّر بعد 2011 يعني أن نفكّر بكرامة، أي أن يترافق تفكيرنا بشعور داخلي باستحقاق الاحترام يترجم إلى احترامِ الآخر والتواصل معه والاعتراف به وبأفكاره وبحقه في الوجود والتعبير. الثقة والهدوء والراحة في العمومي مؤشراتٌ لوجود هذا الشعور بالكرامة. أما الخوف من الانفتاح والهروب من العمومي، والمرور به سريعًا للعودة إلى التكوّر على الذات في دائرة الراحة الجزئية الخاصة، فهي مؤشّرات على نقص هذا الشعور. ويكثر في الغالب الحديث عن نظرية الكرامة عند نقصها على مستوى العمل والسلوك، الذي ينتج بدروه عن نقصٍ في الشعور بأن قناعاتنا (في الوقت الذي نعيشه) تستحق حقًا الاحترام. ومعنى الكرامة هذا يتشكل على قاعدة أخلاقية تشاركية، تنتمي إلى فضاء عمومي سوري، بقدر ما يمدّنا بالشعور بالأمان، والانتماء، بقدر ما يمدّنا بالشعور بالمشاركة في السلطة، والسيادة، والسيطرة، والحصانة تجاه السلطة، والفخر، وغيرها من المفهومات الكفيلة بأن يشعر المرء بكرامته ويعتز، ويهدأ هذا الجزء من شخصيته، فيجد ما يكفي من القدرة للتركيز في الجماليات وطرق الرفاه والسعادة. كل من ليس لديه كرامة لا يزال يفكر قبل 2011، سواء كان من النظام أو المعارضة أو أيًا يكن.
ثالثًا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نفكّر بعزة وأنفة، نستمدّها من مفهوم الشعب الواحد الذي نكوِّنه بوصفنا أفرادًا يتشاركون مشروعَ بناء دولة وطنية سورية عمومية، ومن عضويتنا الطوعية الحرة في جماعاتٍ ثقافيةٍ واجتماعية في مجتمع مدني واسع، ومن انتماءاتٍ كثيرة أخرى على مستوى الحيز الشخصي، نختارها بحريةٍ كما نشاء. يعني هذا، بصورةٍ أخرى، أننا نفكر بالاستناد إلى مبدأ المغايرة والمواطنوية التي بموجبها نحافظ على كل انتماء خاص من طريق الانتماء العمومي، أي من طريق الاعتراف بحق الآخر بالانتماء المغاير ودعم حقه في اختياره، وفي الوقت نفسه، أن نستقوي بجماعاتنا المدينية الحرّة، وبمشروع الجماعة السياسية الموحدة التي تشكل دولةٍ وطنية تنتج منظومةً قانونية، على كل قوةٍ جبريةٍ وعصبيةٍ تحد من حريتنا الفردية.
رابعًا: التفكير بعد 2011 يعني تدريبًا مستمرًا على تكوين الخطاب (discourse) وفهمه، فالخطابات وسيلةُ التواصل في الفضاء العمومي، وأن نفكر بعد 2011 يعني أن نبني للذات صورةً بالخطاب، ونطوّرها بالخطاب الذي يتلاءم مع روح الذات الوطنية وجوهرها، وهو خطاب الحياة والحب والسلم والاندماج الوطني، وكل تفكيرٍ غير سلمي ينتمي إلى ما قبل 2011 (إلا الدفاع عن النفس بوصفه حقا مضمونا ومشروعا) وليس مثل الخطاب شيء يحدّد التخوم بين السلمية والإذعان.
خامسًا: أن نفكّر بعد 2011 يعني أن نفكّر بحرية، أي أن نتحرّر من القصور ونؤهل أنفسنا للفهم والعمل من دون وصاية أحد، أي أن نؤهل أنفسنا لحل مشكلاتنا. والأهم قبل ذلك أن نؤهل أنفسنا للقدرة على تمييز مشكلاتنا؛ فنحن بصورةٍ أولية مطالبون بحلّ المشكلات التي نمتلكها فحسب، لذلك نحن مطالبون بتأهيل أنفسنا لتحديد المشكلات التي نمتلك، فلا نكون مجبرين على التعامل والتفكير في مشكلاتٍ ليست لنا في زمانٍ لا يمنحنا ترف تبذير الوقت. وهذا يعني أمرين: الأول، إنهاء حالة القصور الناتجة عن الإمعية، والفكر العصبوي الذي يلغي التفكير لصالح التبعية التي من شأنها أن تشغل التفكير في مشكلاتٍ لا نمتلكها، مثل المشكلات التي يثيرها نظام القبيلة، والطائفة، والحزب الأيديولوجي، والجماعات المغلقة اللغوية أو الدينية، أو أيًا تكن ماهيتها. واحدة من أكثر صور هذا القصور خطورةً تتمثل في الناتج من التبعية لـ “النخبة”، ومن وصايتها واحتكارها حل المشكلات؛ وكأن النخبة السياسية من شدّة نمطيتها صارت مذهبًا عصبويًا متصلبًا لا يستوي التفكير به من دون أن يتحرّر من طقوسها ومنهجياتها. الثاني، تمييز ملكية مشكلاتنا ومعالجة ما نملكه، فعلى سبيل المثال، ليس لمشكلة “الوحدة العربية” أولوية عمومية لأنها ليست ملكنا، وكذلك الأممية البروليتارية، أو تشريعات لحقوق المثليين؛ فنحن لم نمتلك هذه النوعية من المشكلات بعد، ولن نمتلكها قبل ابتكار الحل الكامل لمشكلاتنا الوطنية. كذلك الأمر مع مشكلات الحيز الخاص، فصناعة العمومي وتمكينه مشكلة نمتلكها، ولكن هذا لا يعني الهجوم على الخصوصي، ولا يمرّ منه، ولا يُسوِّغ تحويله إلى مشكلة عمومية، لأن المشكلات الخصوصية ملكٌ لأصحابها وليست ملكًا لنا جميعًا.
سادسًا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نعي أن الحقيقة لم تكتمل بعد، وسواء كانت إرادة الحقيقة مُشكلًا عموميًا بالمطلق أم لم تكن، فإنها دائمًا لم تكتمل بعد، ولا يمكن أن نفكر بعد 2011 وفي الوقت نفسه نعتقد أن الحقيقة تكونت دفعةً واحدة في مرحلةٍ ما من التاريخ وانتهى الأمر. والثورة في العمق نسفٌ لحقائق زائفة وإحالتها إلى الوهم، مثل الرعوية، وفكر الطاعة، والأب القائد، والحزب التاريخي وغيرها.
سابعًا: أن نفكّر بعد 2011 يعني أن ننسف فكرة البطولة، فالبطل والبطولة ينتميان إلى زمان ما قبل العمومي. وبتعبيرات بريخت في مسرحية “حياة غاليلو”: “ويل لأمةٍ تحتاج إلى بطل”.
وأخيرًا، ليس الصراع في سورية بين نظامٍ ومعارضة، لأن كليهما لا يزال يفكر قبل 2011 (مع أن الفرق بينهما شاسع في المعنى الأخلاقي)، وليس بين شعبٍ ونظام سياسي؛ لأن الشعب مفهوم ينتمي إلى ما بعد 2011 في سورية، ولأن النظام في سورية ليس سياسيًا بل عصابة بلطجية. ولكن جوهر الصراع السوري بين فكرٍ ينتمي إلى ما قبل 2011 يريد قبيلة وتبعية، وآخر ينتمي إلى ما بعدها يريد شعبًا وحرية. والثورة السورية هي ثورة على ذهنية ما قبل 2011 كلها. وإنها لسخرية فاحشة أن تُمثل هذه الثورة بمعارضة سياسية وعسكرية لا تنتمي إليها ولا إلى زمنها، لكن تنتمي إلى زمانٍ قامت الثورة لهدم مفهوماته البالية، ومنها المفهومات الناظمة لعمل المعارضة.
————————
التأويلات الكارثية للثورة السورية/ مضر رياض الدبس
يُحكى أن خالدًا بن الوليد شكَّ في ردّة جماعةٍ عن الإسلام؛ فأسرهم لينظر في أمرهم، وكانت ليلةً باردةً؛ فأمر خالد مناديًا فنادى: “أدفئوا أسراكم”، وهي في لغة الكنانة القتل؛ فظن القوم أنه أراد القتل؛ فقتلوهم، ولم يُرد خالدٌ إلا الدفء. هذا هو التأويل الكارثي: هو تأويلٌ يركن إلى مخزونات الفاهم في لحظة الفهم فحسب، من دون التفكير في الفاعل ومخزوناته ودوافعه وحوافزه ولغته؛ فيفهم المُؤولُ الأمورَ كلَّها بصورةٍ تلقائيةٍ متكرّرة واعتيادية (بالنسبة إليه) تحيل على ذاته وحمولاتها فحسب، من دون أن يُحمِّل نفسه عبء التفكير في حوامل الآخر الفاعل ودوافعه والحوار معه للتحقّق منها. أن نؤول فعلًا ما يعني أن تتدخل منظومتنا الذهنية في فهم هذا الفعل، وهي حتمًا منظومةٌ غير متطابقةٍ مع منظومة الفاعل الذهنية؛ فهذه المطابقة غير ممكنةِ الوجود إلا في صورة وهم. وأن نؤول بصورة كارثية يعني أن نفترض أن هذه المطابقة دائمة الوجود في الواقع: أي أن نستند إلى حمولاتنا الذاتية في الفهم فحسب، وأن نعفي أنفسنا من فعل التفكير الذي يُقلِّب المسائل على أكثر من مستوى معرفي وقيمي، وينظر إلى نسبية المعرفة والحقائق بوصفها ركيزةً مهمةً من ركائز الفهم والتفسير.
يمكن الآن، بعد أن ضبطت السطور السابقة بإيجازٍ ما نعني بـ “التأويل الكارثي”، أن نميِّز بين الثورة السورية بوصفها فعلًا اجتماعيًا والثورة بوصفها تأويلًا لهذا الفعل الاجتماعي من غير الفاعلين به. ونناقش الطرح الآتي: الثورة فعلٌ اجتماعي قام به فاعلٌ يمكن أن نسميه “السوري الجديد” الذي تطوَّر مع الزمان وانفتح على الآخر، وامتلك ذهنيةً جديدةً في التفكير تُحفِّزُه على الحرية، (سمّاها الكاتب في مقاله السابق في “العربي الجديد” ذهنية ما بعد 2011). وتكوّن هذا الفاعل من أفرادٍ سوريين، غالبيتهم من الشباب الذي يمتلك أدوات تواصلٍ معاصرة، وطريقة تفكير وتحليل أكثرَ انفتاحًا على الحياة. هو الشباب الذي نجا من “سرير الأسد” الذي نصبه مثل “سرير بروكروستوس”، وأجبر معظم السوريين على النوم عليه، فـ “مَطَّ القصير وقصَّر الطويل”، حتى صار كل الذين ناموا على السرير على شاكلة صاحبه، ومنهم من معارضيه بطبيعة الحال. وما إن بدأت الثورة بوصفها فعلًا اجتماعيًا، حتى اندفعت إلى فهمها بصورةٍ كارثيةٍ خمسُ مجموعاتٍ من المؤولين، كان لكلٍ منها تأويلها الخاصُ بها؛ فأنتجت خمسة تأويلاتٍ كارثيةٍ:
أولًا، التأويل الأسطوري أو تأويل المعارضة الكلاسيكية: صحيحٌ أن الثورة السورية تأثرت بالثورات في تونس ومصر وامتداداتها في باقي المنطقة، ولكنها بالمعنى المفهومي شأنٌ سوري داخلي محض، يستمد مقومات فهمه العقلانية جميعها من فهم بنية المجتمع والسياسية السوريين، وبنية الحراك الجديد، ومتغيرات العمل السياسي السوري، وبنية الطغمة الحاكمة وآليات قراراتها الداخلية. يعني ذلك أن الاستناد الكامل إلى التصورات الخارجية، مثل تجربة ليبيا للتمهيد لتدخل خارجي، أو تجربة العراق لوضع “لا” للتدخل الخارجي، وإلى ما هنالك من تأويلات تستند إلى الخارج الدولي والإقليمي، ليس إلا واحدًا من انعكاسات فهمِ المعارضة غير العقلاني الذي يستند إلى أساطير وأوهام في رؤوس أصحابها فحسب، تؤدّي إلى تأويل أسطوري للثورة. لم تكن الأحزاب والتجمعات والمنتديات التي تشكل بمجملها المعارضة الكلاسيكية فاعلًا في هذه الثورة، ولم ترتقِ يومًا إلى مستوى الفعل، لأنها لم تبذل الجهد اللازم لفهم الآليات والديناميات الجديدة التي اشتغلت فيها الثورة، ولم تقترب وتتعلم من الشباب الذي يمتلك الثورة، ويمتلك نمط تفكيرها الذي ينتمي إلى المستقبل ويعمل بدلالته، والذي لا يعيش هوويًا في الماضي. مع ذلك، لا يبدو انتشار هذا التأويل الأسطوري خطأ المعارضة فحسب، بل خطأ الثورة الكارثي أيضًا، لأنها أوكلت المهمّة السياسية في الثورة إلى المعارضة الكلاسيكية؛ فنحن ندرك الآن أن هذا التفكير، وإن كان منطقيًا، لكنه لم يكن علميًا، ولذلك لم يكن صحيحًا. إذا آمنت أن السحرَ هو سبب الأمراض كلها ومرضت؛ فمن المنطقي أن تلجأ إلى العرّافة، ولكن هذا منطق أسطوري، يعني غير علمي، وإذا آمنت أن الأمراض هي اضطرابات فيزيولوجية وباثولوجية ومرضت؛ فمن المنطقي أن تذهب إلى الطبيب، وهذا منطقي وعلمي. وخطأ الثورة أنها آمنت بالمعارضة؛ فكانت تفكّر بصورة منطقية ولكن غير علمية؛ وكان هذا خطًأ كارثيًا.
ثانيًا، التأويل الغائي أو التأويل الإسلامي للثورة: يوجد عقلٌ لا يرى الدنيا إلا مع الإسلام أو ضد الإسلام، ولا يتّسع فهمه لمكانٍ ليس له صله بالإسلام، أو لشأنٍ من شؤون الدنيا التي “نحن أدرى بها” بتعبيرات الحديث الشريف، ولا يتسع فهمه أيضًا لكثير الحركات والمواقف والبشر التي ليست مع الإسلام وليست ضده: هي غير معنية بذلك، وتعالج موضوعات منفصلة وحيادية إزاء موضوع الإسلام والأديان، ومنها الثورة السورية؛ فهي في أصلها فعلٌ غير متصلٍ وغير معني بالإسلام لا سلبًا ولا إيجابًا. ويوجد نمطُ التفكير هذا عند جماعتين: الأولى دينية أهمها الإخوان المسلمون والسلفيون وتصنّف نفسها “إسلامية”، والثانية للمفارقة جماعةٌ تعرف نفسها بعدائها للإسلام وتصنف نفسها “علمانية”، ومنها بعضُ الذين يرونَ هويتهم في مصطلح الأقليات الدينية، أو في مصطلح العلمانية فحسب. ليست الجماعة الأولى إسلامية والثانية ليست علمانية، على الرغم من إصرار كليهما على التسميات.
أوّلت الجماعة الأولى الثورةَ بوصفها فعلًا غاياته إسلامية، فلم تخرج هذه القوى في ذلك عن عاداتها في الفهم الرغبوي الذي لا يقيم وزنًا للواقع. وأوَّلت الجماعة الثانية الثورة التأويل نفسه، ولكن تأويلها لم يكن رغبويًا يستخدم للاقتراب من الثورة مثل الإسلاميين، لكن كان هوويًا خائفًا يُستخدم للابتعاد من الثورة ثم الاقتراب من النظام. وفي النهاية، خسر الاثنان أخلاقيًا ووطنيًا، وخسرت الثورة وسورية كارثيًا.
ثالثًا، تأويل معياري إيماني أو التأويل النخبوي للثورة: ليس شرطًا أن تنتمي إلى الدين وتؤمن بالله، لكي تفكر بطريقةٍ إيمانية، وليس شرطًا أن تنتمي إلى قبيلةٍ لتفكّر بصورةٍ عصبية. بل كشفت الثورة أن النخب السورية التي تنتمي إلى ما قبل 2011 هي بصورة أو بأخرى مجموعةٌ مثل الطائفة أو القبيلة، ولكن روابطها أقلّ تماسكًا، وهي عصبيةٌ ركيكةٌ مقارنةٌ بالطائفة والقبيلة. ولكن لها بنية التفكير ذاتها: تفكّر بصورة عصبية وإيمانية مطلقة ويقينية، ولها مقدّسات مثل المقدّسات الدينية، اكتملت في مرحلة ما من تاريخها؛ فلا تتعرّض للنقد أو المراجعة. وفي الوقت الذي كان الإسلاميون فيه يؤولون الثورة بوصفها فعلًا غائيًا غاياته إسلامية؛ كانت النخبة المثقفة أوَلته بوصفه فعلًا معياريًا، يتّخذ من معايريها المسبقة الصنع أنموذجًا للصح والخطأ. مشكلة هذا النوع من التأويلات أنه لا يرى الثورة صالحة، إلا إذا اتّبعت معيارًا واحدًا سائغًا في تقويماتها، في حين أن الثورة فعل عابرٌ للقيم المقولبة، وهي محاولة تاريخية لإبداع قيمٍ أكثر عصرية وأكثر حرية، إضافةً إلى معرفتنا اليوم بأن معايير النخب المقولبة جميعها قد سقطت في امتحان الأحقية منذ 2011. هذا النوع من التأويل كارثي لأنه يعرقل التطور القِيمي الذي تحاول الثورة ابتكاره، ولأنه يقف ضده بصورة إيمانية. نحن لم نستكمل بناء أي نخبة بعد 2011. وحتى حينه، يظل مفهوم النخبة مفهومًا ينتمي إلى ما قبل 2011 وينتج تأويلات غير ملائمة للثورة في أكثر التقديرات تفاؤلًا.
رابعًا، تأويل درامي نفساني: وجد أصحاب هذا التأويل الثورة مسرحية درامية، ينبغي أن يؤدوا فيها دور البطل على الخشبة. وفي الحقيقة، يبدو لأسباب نفسانية تحيل على عقدٍ وأمراض أن هؤلاء لم يميزوا بين الحقيقة والتمثيل. واعتقدوا بصورةٍ راسخة أن مشاهدهم التمثيلية في الثورة فيها متعةٌ للآخرين، وتعود عليهم بالشهرة والنجومية. ومن هؤلاء من صدَّق تمثيله، ولا يزال مقتنعًا بأنه بطلٌ حقيقي، ومنهم من لا يزال يؤدّي أدوارًا مختلفة ومتغيرة ومتناقضة، من دون الشعور بأي مشكلة؛ فهو لا يتصوّر المسائل حقيقية، ويبدو أنه مريض إلى درجة لا يفهم أن هذا الموت الذي نراه حقيقي، وأن بكاء الأمهات لا ينتهي بانتهاء مقابلة تلفزيونية أو مشهد تصويري. لا يزال بعض هؤلاء يقدّم نفسه حكيمًا وسياسيًا بارعًا وبطلًا وحيدًا، والكارثة الكبرى أن بعضًا منهم له أتباع.
خامسًا، تأويل ممنهج أو تأويل الطغمة الحاكمة: هذا هو التأويل الكارثي الوحيد الذي يدرك أصحابه من المجرمين أنه كارثي، والذي يسعى إلى الكارثة بصورة ممنهجة، وتخدمه التأويلات الكارثية الأربعة السابقة من حيث لا تدري، وتشترك معه في الانتماء إلى ذهنية ما قبل 2011.
وختامًا، نقول إن غياب تأويل عقلاني للثورة يُفكر بعد 2011، ويقارب المسائل بدلالة المستقبل، يفسح المجال أكثر للتأويلات الكارثية؛ فيطيل الكارثة كل يومٍ أكثر. وهذا الغياب بحد ذاته كارثي، ينبغي التعامل معه والوقوف في وجه التأويلات الكارثية كلها. والأكيد أن التأويلات الأربعة الأولى جميعها لا تنتمي إلى الثورة، لأن نمط تفكيرها ينتمي إلى ما قبل 2011؛ وأن الطغمة الحاكمة ليست عدوًا سياسيًا للثورة، لكنها عدو تأويلي له ذهنية قاطع طريق إجرامية لا تمتّ للسياسة بصلة.
————————–