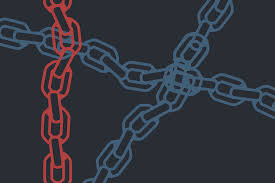عندما لا تتغير الآلهة/ صادق عبد الرحمن

في مقال ريثما لا تتغير الآلهة لسانتياغو آلبا ريكو (ترجمه عن الإسبانية ياسين السويحة)، يقول الكاتب إننا «لو أردنا فعلاً حماية الديمقراطية، فمن الضروري ألّا نتوهم أي عدالة في منطق الامبراطوريات». ليس لديَّ ما أقوله اعتراضاً على هذه الخلاصة، ولا على القول «إننا نساهم في تأخير العدالة» عندما ننحاز إلى إحدى الامبراطوريات متوهمين أنها أكثر عدالة من الأخرى. لكن مع ذلك، ورغم الاتفاق التام مع هذه المقولة، تُرى ما الذي نفعله عندما يتصارع فيلان «امبراطوريان» في غرفتنا؟ خاصة عندما لا يكون لدينا غرفة غيرها.
قد يبدو هذا سؤالاً بالغ الخصوصية، إذ ينطلق من لحظات حرجة كتلك التي تعيشها أوكرانيا اليوم، حيث لا تملك أي جهة سياسية هناك أن تنأى بنفسها عن الانحياز لروسيا أو الولايات المتحدة. وطبعاً، يمكن لأي تيار أو شخص في أوكرانيا أن يقول إنه لن ينحاز إلى أي من «الامبراطوريتين»، أو أن يسعى إلى سياسة خارجية أوكرانية مستقلة عن روسيا وعن حلف الناتو في الوقت نفسه، لكن هذا الموقف يعني، ظرفياً على الأقل، الامتناع عن أي فعل سياسي مؤثر في اللحظة الراهنة. وفي الواقع، إن الكفاح الأوكراني ضد الهيمنة الروسية كفاح عادل، لأن روسيا تسعى إلى حرمان الشعب الأوكراني من حقه في تقرير مصيره بهدف الحفاظ على أمنها «الامبراطوري»، وهو يبقى كفاحاً عادلاً حتى عندما يقود أصحابَه إلى الاندراج في حلف الناتو الذي يدافع بدوره عن أمنه «الامبراطوري»: حتى إذا لم تكن المقاومة الأوكرانية للهيمنة الروسية مبنية على افتراض أن المنطق الامبراطوري الأميركي أكثر عدلاً، بل وحتى إذا تمّت مقاومة الهيمنة الروسية دون أي مساعدة أميركية-أوروبية، فإنها ستصبّ ظرفياً في صالح المنطق الامبراطوري الأميركي.
أيضاً، قد يبدو السؤال عن الفِيَلة التي تتصارع في «غرفتنا» سؤالاً سورياً صرفاً، إذ تحضر دول إقليمية وعظمى عديدة في سوريا بجيوشها وأتباعها، ويبدو مستحيلاً على أي طرف سوري أن يحافظ على وجوده دون الاحتماء بإحدى القوى الأجنبية ذات المنطق الامبراطوري. لكن رغم أن السؤال يبدو مرتبطاً بأوضاع استثنائية كما هو حال أوكرانيا وسوريا، إلا أنه يتجاوز زماناً معيناً في مكان معين، وذلك لأن الجميع مُعرَّضون في كل وقت للوقوع في أوضاع قصوى كهذه، ولأن المنطق الامبراطوري يحكم سياسات الدول العظمى تجاه جميع القضايا العالمية، بل وسياسات دول أقل نفوذاً مثل تركيا وإيران بمطامحهما الامبراطورية.
والمنطق الامبراطوري، كما عرّفه بيركليس في إحدى خطبه أثناء الحرب بين أثينا وإسبارطة، يقول إنه لا مكان للحديث عن العدالة والديمقراطية عندما تكون الامبراطورية في مواجهة امتحان البقاء. يشرح سانتياغو آلبا في مقاله كيف تم دفع هذا المنطق إلى أقصاه في سياق الحرب الباردة، ثم كيف أننا نعيش اليوم في إطار جيوسياسي «لا مكان فيه للديمقراطية والعدالة، ولا حتى على سبيل البروباغندا». هكذا يبدو أن المنطق الامبراطوري الراهن يعيش دائماً في امتحان بقاء، بحيث لا يجد أصحابه حرجاً في احتقار الديمقراطية والعدالة في كل وقت. ولهذا فإن إقامة العدل ونشر الديمقراطية ليست ممّا يمكن الرهان على الامبراطوريات لإنجازه، بل هي ممّا يجب أن نكافح لأجله نحن المواطنون، و«هذا يقتضي الضغط على الأطراف، دون بناء أي أوهام حول منسوبها السياسي والأخلاقي» على ما يقول سانتياغو آلبا في مقاله مُحقّاً.
ولكن كيف يمكننا فعل هذا بينما لا تترك الدول «الامبراطورية» مساحات فارغة في أي مكان؟
لدينا تجربة عملية في سوريا عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بالحرية والعدالة، وتم إدراجهم رغم أنوفهم في سياق محاور وصراعات جيوسياسية كبرى. اتهمهم النظام بالتآمر لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وأمعنَ في حفلة القتل والتعذيب الرهيبة حتى حملت مجموعات من السوريين السلاح، للدفاع عن النفس في البداية ثم بهدف حسم المعركة. استعان نظام الأسد بإيران وروسيا، فيما استعان خصومه ومنافسوه على السلطة، الذين صاروا فصائل وتنظيمات متنوعة ومتصارعة أحياناً، بتركيا ودول خليجية وغربية. هكذا جاءت «الامبراطوريات» الكبيرة والصغيرة كلّها إلى بلدنا لتُدافع عن «مصالحها الجيوسياسية»، فساهمت في جعله مسرحاً مفتوحاً لاحتقار العدالة، بل وجاءت معها أطياف امبراطوريات مندثرة، حتى أن تنظيماً إجرامياً مثل داعش أعلن عودة الخلافة الإسلامية من الأراضي السورية.
ولكن ما الذي قاد إلى هذا الجحيم في سوريا؟
طبعاً لدى أنصار المنطق الامبراطوري الروسي الواثق من نفسه جواب جاهز: السبب هو المطالبة بالديمقراطية في بلد يعيش ظروفاً جيوسياسية غير ملائمة، والظروفُ غير الملائمة المقصودةُ هنا هي الخطر الداهم الذي يتمثّل في أن يصبح البلد حليفاً للدول الغربية. وهناك أجوبةٌ أخرى كثيرة تفوح منها رائحة الجيوسياسة والامبراطوريات، أغلبها يتعلّق بإسرائيل وتأثيرها على مآلات الأمور في البلد. وقد تحتمل أيٌّ من هذه الإجابات قليلاً أو كثيراً من الصواب إذا كان القصد منها تفسير ما حصل (الحفاظ أمن إسرائيل مثلاً كان على الأرجح عاملاً حاسماً في كل التفاهمات الروسية الأميركية بشأن سوريا)، لكن أصحاب المنطق الإمبراطوري لا يستخدمون هذه الإجابات للفهم والتفسير، بل لإلقاء اللائمة على أولئك الذين لم يدرسوا علوم الجيوسياسة جيداً قبل أن يطالبوا بحقهم في أن تتوقف عائلة الأسد ومحاسيبها عن نهبهم وإذلالهم. بالنسبة لبعض هؤلاء، يتم إخراج الطغيان والقمع والنهب من دائرة الأسباب التي قادت سوريا إلى هذا المصير، لتصبح المشكلة كلّها في خيارات وسلوك أولئك الذين تمردوا على هذه الأوضاع.
بعيداً عن الإجابات السابقة، ثمة إجابات أخرى متنوعة يحاول أصحابها تفسير ما حصل في سوريا، بعضها يُحيل إلى مشكلات في التكوين التاريخي للبلد، وبعضها إلى مشكلات في الثقافة السياسة السورية، وبعضها إلى تخلّي الثوار عن الكفاح السلمي ورهانهم على السلاح. ومن بين الإجابات الرائجة واحدةٌ تقول إن الخطأ كان في رهان المعارضين على مساعدة غربية، أي في الرهان على أن المنطق الامبراطوري سيدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تدخّل حاسم ضد النظام وحلفائه.
وبالفعل، كنّا نقول إن «العالم» لن يتخلّى عنا، وكان «العالم» المقصود طبعاً هو أوروبا والولايات المتحدة وحلفاؤهما في المنطقة. لكن هل كان هذا رهاناً على عدالة كامنة في المنطق الامبراطوري الأميركي؟
في الحقيقة، كان الأمر كذلك بالنسبة لبعض المعارضين والثائرين فقط، فيما كان التصوّر العام الأكثر شيوعاً يفترض أن المصالح الغربية في مواجهة روسيا وإيران ستدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التدخل، وأن هذه المصالح ستكون مدعومةً برأيٍ عامٍ نشط مناهض للطغيان في الدول الديمقراطية. سنعرف لاحقاً بأسوأ الطرق أن هذا التصوّر لم يكن صحيحاً، ولكن بصرف النظر عن هذا: ترىُ هل كان رهان خصوم النظام على مساعدة غربية واحداً من بين خيارات متعددة يمكنهم أن يختاروا بينها؟ وهل كان في وسع المعارضين السوريين ألاّ يراهنوا عليها فتنتهي المسألة عند هذا الحد؟ أخشى أن الأمر لم يكن كذلك في أي وقت، وأنه لم يكن هناك طريقة لتجنب الرهانات المتبادلة على دعم قوى خارجية سوى أن يسير النظام في عملية انتقال ديمقراطي تعفيه وتعفي خصومه من سفك الدماء، وهو ما لم يحدث.
وبعد ذلك، بعد أن جاءت التدخلات الأجنبية إلى سوريا وصارت أمراً واقعاً، ترى أين يقع الخط الفاصل بين الرهان على امبراطورية يمكن أن تدفع بعض الأذى عنا، وبين الرهان المُضلِّل على عدالة لا وجود لها في المنطق الامبراطوري؟ هل ساهمنا في تأخير العدالة عندما راهنّا على ضربات غربية بعد أن ارتكب النظام مذبحته الكيماوية في غوطة دمشق عام 2013؟ أم أن الذي داس العدالة هو الاتفاق الروسي الأميركي الذي اكتفى بخطة غير مضبوطة لسحب سلاح النظام الكيماوي، وسمح له بمواصلة حربه بسائر الأسلحة الأخرى بما فيها معسكرات الموت تحت التعذيب في صيدنايا وغيرها؟
في هذه الحكاية الكئيبة، يظهر المنطق الامبراطوري المناقض جوهرياً للعدالة والديمقراطية، وتظهر معه صعوبة الكفاح لأجل العدالة بينما يهيمن المنطق الامبراطوري على الخطاب والعمل السياسيَين في كل مكان من العالم، إذ شهدت سوريا حروباً طويلة متداخلة وانتهاكات وجرائم واسعة، برعاية «امبراطورية» من دول عديدة عظمى وإقليمية. لكن هذه الحكاية الكئيبة ليست حكاية سوريا وحدها، بل هي في بعض وجوهها حكاية عالمنا كلّه في الظروف الراهنة، حيث لا مساحات فارغة من الحضور الامبراطوري الطاغي، وحيث يصير العالم قرية ضيّقة بدل أن يصير قرية صغيرة وفقاً للتعبير الرائج.
في ملحمة الإلياذة، التي يُرجَّح أن هوميروس كتبها قبل الحرب بين أثينا وإسبارطة وخطاب بيركليس بعدة قرون، لم تكن الآلهة تكفّ عن التدخل وفرض إرادتها لتغيير مجرى الأحداث في حرب طروادة، ولم يكن المتحاربون يستطيعون مواصلة الحرب دون استجداء مساعدة الآلهة بين وقت وآخر. يبدو أن المنطق الامبراطوري الراهن عالقٌ هناك، حيث لا مساحات ممكنة للعمل السياسي والكفاح من أجل التغيير دون الخضوع للامبراطوريات ومنطقها ومصالحها. وبالفعل، لن تتغيّر الآلهة الامبراطورية «ما لم نضع، نحن الضحايا، عثرات في طريقها» كما يختم سانتياغو آلبا مقاله. ما يسعني أن أضيفه هو أن ما جرى في سوريا وبلدان كثيرة غيرها، وما قد يجري في أوكرانيا، يخبرنا أننا نحتاج حراكاً عالمياً واسعاً عابراً للحدود، يفرض نفسه على الامبراطوريات ومنطقها، ويقدم عوناً حقيقياً ملموساً لمن يجدون أنفسهم عالقين في غرفتهم مع فيَلة متصارعة. بدون تحالف عالمي واسع وفعّال كهذا، الأرجح أن الآلهة لن تتغير، وأن العالقين سيجدون أنفسهم مِراراً مضطرين للاحتماء بأحد الفِيَلة.
موقع الجمهورية
———————–
ريثما لا تتغيّر الآلهة/ سانتياغو آلبا ريكو
ترجمة: ياسين السويحة
ثمة فيلم روسي ممتاز، عنوانه ما أصعب أن تكون إلهاً، أخرجه أليكسي جيرمان عام 2013 مقتبساً من رواية خيال علمي شهيرة، يروي فيها الأخوان ستروغاتسكي هبوط بعثة فضائية (سوفيتية؟) في كوكب أركانار، حيث تمكَّنَ انقلاب عسكري خبيث من وقف الانتقال ما بين العصور الوسطى وعصر النهضة. في القصة، يتوجّب على الباحثين الأرضيين الواصلين في البعثة أن ينغمسوا ضمن هذه الحضارة المتأخرة ويدرسوا عمليات الانتقال والرسوخ التاريخية، لكنَ أيَّ تدخّل في مجرياتها ممنوع عليهم منعاً باتاً. تكمن صعوبة أن تكون إلهاً هنا بالذات، في أن تنأى بنفسك عن الصراعات الجارية على الأرض رغم امتلاكك الموارد اللازمة للتدخل. الإله قادر على كل شيء إلا على لجم نفسه، فقدرته على الفعل هي التي تقرر بذاتها، وبلا هوادة.
ليس سهلاً أن تكون امبراطورية، أو قوّة عظمى على الأقل. كثيراً ما يُحال إلى «خطاب التأبين» لبيركليس عام 431 قبل الميلاد، أول أعوام الحرب البيلوبونيسيّة بين أثينا وإسبارطة، وهو خطاب صادمُ الجمال، لكن يشيع أن يُنسى إكماله بخطاب آخر ألقاه بعدها بأشهر، حين بدأت الحرب تميل نحو الكفة الأسبرطية. فإزاء سخط الأثينيين، ترك بريكلس دائرة المُثُل لينزل إلى ضيق وحل الواقعية: لم تعد المسألة هي الديمقراطية، يقول، بل «خسران امبراطورية». مُطلِقاً تحذيراً في وجه الأرواح الدرويشة: «لم يعد من الممكن التنازل عن هذه الامبراطورية، إن كان منكم من يشعر بالخوف إزاء الوضع الراهن، أو ينوي اتخاذ دور الإنسان الطيب سعياً وراء رغبته بالهدوء». ليختم بعدها: «إن هذه الامبراطورية التي بحوزتكم قد باتت بمثابة طغيان: يبدو إحرازها ظالماً، ولكن التخلي عنها شديد الخطورة». من الصعب أن تكون إلهاً لأن على الإله أن يكون موجوداً في كلّ مكان، ولأن أي تضعضع في وجوده الكلي هذا قد يعني خطر التلاشي التام. لا يلعب العدل ولا الديمقراطية أيّ دورٍ هنا، كما هو مثبت في حوار ميلوس، والسجال بين كليون وديودوت الأثينييَّن حول مصير الميتيلينيين، كما ورد في سرد ثوقيديدس.
لطالما أغرت مقارنة الحرب البيلوبونيسيّة بالحرب الباردة المؤرخين، وإن انطلاقاً من اصطفافات إيديولوجية أو أخلاقية دوماً: إسبارطة التسلطية بمثابة الاتحاد السوفيتي من حيث المبدأ، في حين تتمثل الديمقراطية الأثينية في الولايات المتحدة. ليست هذه طريقة جيدة للتمحيص. فإن كان من الممكن إنشاء متوازيات بين أحداث تاريخية على هذه الدرجة من الاختلاف، فذلك لأن الحرب الباردة قد أخذت «المنطق الامبراطوري» الذي عرّفه بيركليس إلى أقصاه، أي النأي عن العدالة والديمقراطية، والاضطرار لملء كل الفراغات، حتى بما يُناقض المصالح الاقتصادية الذاتية. لم يكن التدخل في فيتنام، حيث مُنيت الولايات المتحدة بهزيمة مذلّة، للاستحواذ على مصادر طاقة أو ثروات منجمية يفتقر إليها ذلك البلد؛ ولم يكن للمستنقع الأفغاني، مقبرة الاتحاد السوفيتي، أيّ مبرر، بل كان الضرر واضحاً من وجهة نظر برغماتية. نضيف على ذلك أن الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة هو ملاحقة شيوعيين وقتلهم.
وإذ اعتقد المرء أن نهاية الحرب الباردة ستحمل على الأقل فائدةَ إمكانيةِ دراسة «المنطق الامبراطوري» وإدانته، بمعزل عن الاصطفاف الإيديولوجي وأوهام الحقيقة والعدالة والتفوق الديمقراطي، تبدو استعادة المثنوية لنشاطها مع الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة مثيرة للاستغراب، فعقلنا نصف الكروي يتغلب -دعونا نقول- على فكرنا المتعدد. قبل أحد عشر عاماً، ناصرتُ الثورات والانتفاضات «العربية»، مسترشِداً وسط الضباب بمعايشات قريبة ومعرفة عنيدة. بإمكان أيّ أحد أن يعتبر أنني أخطأت، لكنني ما زلت أعتقد أن الشعوب والوقائع والمبادئ دلّت على أنني كنت على حق، وما زلت. يحصل منذ ذلك الوقت أن أجدَ نفسي بين حين وآخر فيما يشبه انتكاسات الحمّى المالطية، إذ أتعرض لشتائم وأكاذيب وتهديدات. لقد حصل ذلك مجدداً، فرغم أنني لم أكتب شيئاً حول أوكرانيا، إلا أن بعض المجهولين الرقميين -الذين لن أوجه لهم رداً أو «بلوك»- يوجّهون لي هذه الأيام تهماً متنوعة (عميل للناتو، مرتزق وكالة المخابرات الأميركية ومؤسسة فورد..) وسيلاً منفلتاً من الشتائم. أحدهم قال عني إنني «كلب متمسّح بساق الإمبراطورية»، وآخر أرعد حكماً: «أيّ مجرمٍ هذا، سانتياغو آلبا». أيّ مجرم! تملّكتني عند قراءة هذا الكلام رغبة باستخدام اقتباس ساخر للمتتالية الجُرمية حسب توماس دي كوينسي: يبدأ المرء بالمرافعة لأجل الديمقراطية في «العالم العربي»، وبعدها يتسبب ببكاء طفل، ثم يسرق عكازة عجوز، وبعدها يجزّ عنق زوجته، وبعدها، بكامل الحصانة، يجتاح بولونيا. أيّ مجرمٍ! ولعلّ بوسع المرء أن يعتبر هذا الكلام ضرباً من المبالغة اللفظية، لولا أن هذه اليافطة تخفي وراءها حصراً خطيراً للمعنى، كثمرة متأخرة للقرن العشرين ومبكرة للواحد والعشرين، أي السعي لمسح الفارق بين الاختلاف والجريمة: من لا يفكر مثلي -بوصفي تجسيداً للحقيقة المطلقة- لا يرتكب خطأً، لا؛ بل إنه يغتصب أطفالاً ويدمّر مدناً ويبيد شعوباً بأكملها بالغاز. هذه هي الطريقة التي يقيس بها العالمَ أولئك الذين أسميتهم «ستاليبانيين»1. الستاليباني عاجزٌ عن القبول باحتمال أن يكون مخطئاً، ولذلك لا يقبل أيضاً احتمال أن يكون الآخر مخطئاً: الآخر لا يخطئ، بل هو منخرطٌ «موضوعياً» في مؤامرة إجرامية مُحكَمة، تتوجّب مكافحتها بكل السبل الممكنة. كلّ من لا يفكر كما أفكر هو قاتل، ويستحق بالتالي أن يُقتَل، افتراضياً أو فعلياً.
أشير إلى هذه اللآلئ السوداء بوصفها تعبيرات قصوى عن المثنوية الامبراطورية، القابعة أيضاً في رؤوسٍ أكثر اعتدالاً، وأحزاب من هذا التوجه أو ذاك، مثنوية نرى قيامها المتحمس هذه الأيام. ليس بوسع الستاليبانيين، ولا توائمهم السيامية «الليبرالية»، الاكتفاء بدراسة المخاطر والدفع نحو مفاوضات واقعية؛ بل يستسلمون لاستقطاب الحرب الباردة الإيديولوجي: عليهم أن يثبِتوا وجود شرّ، وفي الوقت نفسه أن يكونوا «أناساً أخيار»، متناسين تعاليم بيركليس بأن لا معنى لإجراء مقارنات حول أعداد القتلى، وبالذات لا معنى لمحاولة تبرير نصف هذه الأعداد، هناك حيث يهيمن «منطق امبراطوري» موازٍ للعدالة والديمقراطية. لا تكمن المسألة في الانحياز لطرف مقابل آخر، بل في الإشارة لـ «المنطق الامبراطوري» بحدّ ذاته، والتخلّي له عن أقل مساحة ممكنة في سبيل الحفاظ على السلام. وبما يخص الخصام بين روسيا والولايات المتحدة، فلا يسعني أن أقول أكثر من التالي: ليس التسويغ القيمي لأيّ من الطرفين الامبراطوريين مقبولاً بالنسبة لي، فالمسألة واقعياً يجب أن تكمن في نزع سلاح كليهما. من السخف بمكان أن تُتناسى تسلطية بوتين، وجرائمه في الداخل والخارج، في سبيل تطويبه كرمز مناهض للامبريالية فقط لأنه يخوض مواجهة مع الولايات المتحدة. من الجهة المقابلة، ورغم إمكانية أن تقدم ديمقراطية الولايات المتحدة الذابلة بعض الدروس لبوتين في المجال، إلا أنه من السخف إقناع النفس بأن الولايات المتحدة قد سعت يوماً لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان حيثما انتشرت عسكرياً، متسببةً بالكلف الإنسانية التي نعرفها جميعاً. روسيا والولايات المتحدة عالقتان في «منطقهما الامبراطوري»، في إطار عالم القرن الواحد والعشرين الجيوسياسي، المختلف عن إطار الحرب الباردة؛ إطار لا مكان فيه للديمقراطية والعدالة، ولا حتى على سبيل البروباغندا. الديمقراطية والعدالة، في مواجهة «المنطق الامبراطوري» متعدد الأقطاب، هي قضايا يجب أن نتنطع لها نحن المواطنون، وهذا يقتضي الضغط على الأطراف، دون بناء أي أوهام حول منسوبها السياسي والأخلاقي. إننا نساهم في تأخير العدالة كلّ مرة ننحاز فيها لـ «منطق امبراطوري» ما، مقتنعين أن أحد الطرفين أكثر عدالة أو أكثر ديمقراطية من الآخر، إذ هكذا نغذي صراعات عسكرية، سبّبت آلامَ آلاف الضحايا، وكبتت صوت الإنسانية لعقود. دعونا لا ننسى أن الحرب البيلوبونيسيّة انتهت متسببة بموت الديمقراطية الأثينية.
ما هو الحدّ الأدنى الذي يجب أن يُعترَف به لـ «المنطق الامبراطوري» الروسي؟ ما تريده روسيا البوتينية هو فرض حقها في أن يُعترف بها قوّةً عظمى عالمية، وأن تتصرف وفقاً لذلك. «حقّها» بالمعنى الجيوسياسي، أي «قوّة» و«موارد». أتمتلكهما؟ أخشى أنها تمتلكهما. هذا يقتضي الاعتراف لها بـ«حقّها» في التفاوض على «أمنها القومي». ليس مقبولاً بالنسبة لي الاعتراف لها بأي شيء آخر، ولا من المقبول تجاهل ملاحقاتها للمعارضين في الداخل، ولا وحشيّتها في الشيشان، ولا قصفها للمدنيين في سوريا. ولا من المقبول إنكار حقّ الشعب الأوكراني -وهنا نتحدّث عن حق إنساني وقانوني- في الدفاع عن نفسه ضد غزوٍ سيتناقض، في حال حصل، مع «المنطق الامبراطوري» الراهن.
وما هو الحدّ الأدنى الذي يجب أن يُعترَف به لـ «المنطق الامبراطوري» للولايات المتحدة؟ الحق الجيوسياسي، وليس الديمقراطي، بأن تتفاوض مع روسيا حول الترتيب ما بعد السوفيتي لأوروبا، الواقع على بُعد آلاف الكيلومترات من أرضها. ليس من المقبول بالنسبة لي الاعتراف بأكثر من ذلك. ولا من المقبول تجاهل الانقلابات والاجتياحات وحملات القصف في الخارج، أو السياسات العرقية والاجتماعية في الداخل. ولا ينبغي تجاهل قسط الولايات المتحدة من المسؤولية لو حصل أن اجتازت قوّات ودبابات روسيا البوتينية حدودها مع أوكرانيا، في تناقض مع «المنطق الامبراطوري» الراهن.
وماذا عن الاتحاد الأوروبي؟ لو قصدنا الحديث عن العدالة والديمقراطية، فعليه أن يفعل ما بوسعه كي لا يشبه روسيا البوتينية. أما بخصوص «المنطق الامبراطوري»، أي المصالح الجيوسياسية، فعلينا أن نقتنع أن استمراريته تقتضي عدم انحيازه، أو على الأقل عدم انحيازه بشكل غير مشروط، مع الولايات المتحدة. لا شيء يسبب لي الدوار بقدر تصوّر اتحاد أوروبي أكثر بوتينية في الشأن السياسي، وأقل استقلالية في الجيوسياسة، وهو تصوّرٌ لا يستحيل حصوله، وتغذّيه الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي ودوره المعدوم في التفاوض مع روسيا. يتقلص دور أوروبا في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان مع الوقت، وتعرض استقلاليةً «امبراطوريةً» أضعف من حلفاء مشاكسين وقساة مثل إسرائيل والسعودية وتركيا. أوروبا أسيرة حلفِ ناتو يقتصر دوره على ضبطها داخل دائرة الولايات المتحدة، وهذا سيء للجميع. إذ فقط اتحاد أوروبي مستقل وديمقراطي قادر على المساهمة في تقليص «منطق الامبراطوريات»، المترتب مجدداً، والمهدد للسلم العالمي.
يصعب أن تكون إلهاً، أو امبراطورية أو قوّة عظمى. لكن من الملائم أن ننشغل بضحايا هؤلاء أيضاً. لو أردنا فعلاً حماية الديمقراطية فمن الضروري ألا نتوهم أي عدالة في منطق الامبراطوريات، ولو أردنا تصويب منطق الامبراطوريات، ولو بدرجات صغرى، فعلينا ألا ننسى العدالة والديمقراطية. لنتذكر تحذير سانشيث فيرلوسيو: «لن يتغيّر شيء ما لم تتغيّر الآلهة». ولن تتغيّر الآلهة ما لم نضع، نحن الضحايا، عثرات في طريقها.
نُشر النص الأصلي للمقال في جريدة بوبليكو الإسبانية.
1. اجترح الكاتب التسمية من دمج «ستالينيين» و«طالبانيين». (المترجم).
موقع الجمهورية
Hard to Be a God
https://www.imdb.com/title/tt2328813/
———————