ماذا بعد غزو روسيا لأوكرانيا؟ -مقالات مختارة-

تحديث هذا الملف يومي، نضيف العديد من المقالات المهمة والمختارة التي تناولت الحدث. أنظر في الأسفل
من الذي يريد الحرب بايدن أم بوتين؟/ عبد الحميد صيام
تخيلوا معي للحظات أن انقلابا يساريا حدث في جمهورية المكسيك واستقرت الأمور لحكومة يسارية، وطلبت هذه الحكومة أن توقع اتفاقية دفاع مشترك مع الاتحاد الروسي خوفا من الجار الأكبر في الشمال فماذا سيحدث؟ وكيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ وهل ستقبل أن تنضم المكسيك إلى تحالف مع خصم استراتيجي مثل روسيا؟
هذا ليس سيناريو خياليا فقد حدث عدة مرات في أمريكا الوسطى والجنوبية، وفي كل مرة تقوم الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا أو عن طريق إثارة الاضطرابات لإسقاط النظام اليساري. فقد كادت الولايات المتحدة أن تدخل حربا نووية عام 1962 عندما قام الاتحاد السوفييتي بنشر صواريخ نووية في كوبا ردا على محاولة الولايات المتحدة إسقاط نظام كاسترو فيما عرف بـ «خليج الخنازير» وانتهت الأزمة بسحب الصواريخ السوفييتية من كوبا والصواريخ الأمريكية من تركيا.
الولايات المتحدة أسقطت نظام سلفادور أليندي اليساري في تشيلي عام 1973، وغزت بنما عام 1989، وغزت جزيرة غرانادا في الكاريبي عام 1983 وأسقطت نظام موريس بيشوب، وأسقطت النظام المنتخب في الجمهورية الدومينيكية عام 1966 ونصبت ديكتاتورا دمويا هو خواكيم بالاغوير، وفي غواتيمالا أسقطت النظام المنتخب عام 1954 وكان آخر تدخلاتها بإسقاط إيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا عام 2019 إلا أن الشعب هناك عاد وانتخب حزب موراليس مرة ثانية «وفرك بصلة في عين ترامب». ولا ننسى ما قامت به الإدارات الأمريكية في فنزويلا منذ انتخب هوغو شافيس عام 1999 وخلفه نيكولاس مادورو عام 2013 ومحاولات إسقاط النظام عن طريق الانقلابات العسكرية أو تدمير الاقتصاد أو دعم المعارضة أو كلها مجتمعة. فلماذا ليس من حق روسيا ألا تنزعج لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو لتطويق روسيا من كافة الجهات بالقوات العسكرية لأكثر من 30 دولة غالبيتها انضم إلى الحلف في العشرين سنة الماضية وآخرها مقدونيا الشمالية عام 2017؟ لماذا حلال على الولايات المتحدة التدخل في شؤون حديقتها الخلفية، كما تسميها، ولا يحق لروسيا أن تحمي أمنها بمنع أوكرانيا وجورجيا من الانضمام للناتو وكلتا الدولتان كانتا جزءا من الاتحاد السوفييتي لأزيد من 70 عاما وتضم كل منهما أقليات روسية كبيرة؟ أيجوز أن يكون هناك قانون للدول الغربية لحماية أمنها ولا ينطبق هذا القانون على غيرها من الدول الكبرى مثل روسيا والصين؟
الوضع الداخلي لبايدن وأسباب التصعيد
يمر بايدن هذه الأيام في أسوأ مرحلة منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام كامل. وتشير استطلاعات الرأي الى أن نسبة غير الراضين عن أدائه ارتفعت إلى أعلى مستوياتها لتصل إلى 53.6% وأن نسبة الراضين عن أدائه لا تتجاوز 41% حيث ما فتئتت تنخفض منذ آب/أغسطس 2021 الماضي بعد هزيمة أفغانستان. لكن الأوضاع الداخلية أسوأ بكثير مما هو شائع، ولنراجع مجموعة قضايا:
– وصلت نسبة التضخم 7.5% وهي أعلى نسبة منذ أربعين سنة. وهذا ما يهم الأمريكي الذي كان يملأ خزان سيارته العادية بنحو 30 دولارا عليه أن يدفع الآن نحو 50 دولارا. لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والمحروقات والعقارات وغيرها. الناس تشكو من الغلاء غير المسبوق، وبايدن يتخبط ولا يعرف كيف يوقف ارتفاع الأسعار الذي أثر على الأسواق المالية حيث تشهد أسعار الأسهم هبوطا وصعودا يوميا.
– ما زالت جائحة كورونا ومتحوراتها منتشرة بشكل واسع وقد زاد عدد الوفيات عن 900000 شخص وهي أعلى نسبة في العالم قياسا لعدد السكان. لقد وصل بايدن البيت الأبيض وهو يرغي ويزبد مؤكدا أنه سيقضي على الوباء الذي تفاقم بسبب سياسات سلفه ترامب، كما أكد مرارا. لكن الوباء بعد سنة كاملة، ما زال منتشرا ولا تظهر في الأفق بوادر لاحتوائه.
– تقترب الانتخابات النصفية من موعدها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي تعتبر مرآة تعكس مدى رضى الناس عن الإدارة الحالية بعد سنتين تقريبا. ومن الواضح لبايدن والحزب الديمقراطي بقياداته الكلاسيكية أن الحزب سيتعرض لهزيمة قد تكون كبيرة. كما أن هناك العديد من المعطيات تشير إلى عودة الترامبية بقوة إن لم تكن بشخص ترامب فستكون بنماذج مستنسخة عنه قد تكون أكثر تطرفا وشعبوية.
لهذه الأسباب جميعا، إضافة إلى فضيحة أفغانستان وغيرها، يدق بايدن طبول الحرب ليحشد الشعب الأمريكي خلفه لأنه يواجه الخطر الروسي. ألا يذكرنا هذا بطبول جورج بوش وهو يحضر لغزو العراق وموجة الهستيريا التي كانت تتحدث عن الخطر الذي يمثله صدام حسين ونظامه وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى التي سيطلقها صدام ضد الحلفاء. سلسلة الشيطنة والهستيريا والافتراءات تتكرر من بلد تدخل 70 مرة في دول خارج حدوده لتغيير النظام.
ماذا يريد بوتين؟
نختلف كثيرا مع الرئيس بوتين وسياساته في كثير من المسائل مثل موقفه من سوريا وعلاقته المميزة مع الكيان الصهيوني وغض الطرف عن الغارات الجوية التي يقوم بها الكيان على سوريا دون أي رد فعل روسي. نختلف مع دعمه للانقلابات العسكرية ومساندة دول الاستبداد والمنشقين مثل خليفة حفتر في ليبيا، وعسكر ميانمار والسودان، ونختلف معه في إرسال مرتزقة الفاغـنر إلى ليبيا وتشاد وغيرها. ونختلف معه في تمسكه باللجنة الرباعية حول تسوية القضية الفلسطينية التي ماتت وشبعت موتا ولم تحقق اللجنة إلا إعطاء غطاء لإسرائيل لابتلاع مزيد من الأرض ونقل مزيد من المستوطنين إلى قلب الأرض الفلسطينية وتهويد القدس، وخلق حقائق على الأرض تجعل إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمرا مستحيلا. لكننا نتفق مع سياسة روسيا فيما يتعلق بالوقوف أمام البلطجة الأمريكية ومحاولات الهيمنة والاستفراد بالقرار الدولي وتكريس عالم القطب الواحد الذي تعرض للتراجع عام 2003 بعد فشل الولايات المتحدة اعتماد قرار في مجلس الأمن تأييدا لغزو العراق. ومنذ ذلك الوقت والولايات المتحدة تشهد انحدارا في مكانتها العالمية. كما برزت مجموعة قوى تبحث عن مكان لها في المنظومة الدولية من بينها الصين وروسيا ومجموعة دول بريكس التي تضم البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وتحول مجلس الأمن الدولي من آلية خاضعة لإملاءات الولايات المتحدة بين عامي 1990 و2003 إلى مجلس متعدد الأقطاب لا يتم اعتماد قرار إلا بالتوافق.
لقد أعاد بوتين منذ تولى قيادة البلاد عام 1999 لروسيا مكانتها ودورها بعد أن مرغ بوريس يلتسين هيبة البلاد في التراب، وكان الغرب سعيدا به وراضيا عن أدائه حتى ولو قصف مقر الدوما الروسي بقذائف الدبابات. عشرون سنة في الحكم، رغم كثير من التحفظات على آلية الانتخابات، إلا أن روسيا تعافت اقتصاديا وأصبحت لاعبا أساسيا على المستوى الدولي لا يمر قرار بدونها سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو إثيوبيا أو الصومال أو مالي أو ميانمار أو كوريا الشمالية.
لقد أحس بوتين أن حلف الناتو بدأ يقترب أكثر فأكثر من عنق روسيا بعد توسيع الحلف ليشمل دول البلطيق والبلقان وأوروبا الشرقية ولم يبق إلا جورجيا وأوكرانيا. إضافة إلى ذلك قامت الإدارة الأمريكية بنشر مزيد من القوات في الدول القريبة من روسيا مثل رومانيا وبولندا وإستونيا. وقام بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بما في ذلك صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، وأنفق ما يزيد عن 700 مليون دولار لتحديث القدرات الدفاعية والتسليحية والبنى التحتية لأوكرانيا. من جهة أخرى أطلق بايدن حملة شيطنة ضد بوتين وراح يؤكد مرة وراء مرة أن غزو أوكرانيا بات وشيكا وراح يحدد مواعيد بدء الهجوم الروسي مع أن روسيا ما فتئت تنكر نيتها لغزو أوكرانيا. الرئيس الأوكراني، فلودمور زيلنيسكي، القادم من عالم الكوميديا، تنقصه الخبرة وقلة الحيلة وقد اتسمت سنواته الثلاث بفضائح الفساد ومحاباة الأقارب والأصدقاء وانخفضت شعبيته إلى أقل من 25 % بعد أن حصل في انتخابات 2019 على 73%. لقد سلم أمور أوكرانيا إلى الولايات المتحدة لتنصب الشرك للاتحاد الروسي، فإما أن يقع فيه ويتم إنهاكه عسكريا أو يتم فرض جزاءات قاسية ويتم إنهاكه اقتصاديا. وفي كلتا الحالتين، يجري ضرب الاتحاد الروسي إما عسكريا أو اقتصاديا أو بكليهما ثم ينتقلون للصين للاستفراد بها. لكن بوتين ثعلب السياسة الماكرة وخريج الكي جي بي، أوقعهم في شر أعمالهم فبدل الحرب الشاملة، اعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وقرر إرسال قوات حفظ سلام وإقامة قواعد عسكرية هناك. أي أنه تحكم في أوكرانيا دون أن يحتلها عسكريا وأصبح لديه الآن من أوراق التفاوض ما يجبر قيادات الناتو والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة أن تفاوض من موقع ضعف مضطرة أن تصل معه إلى اتفاقية أمنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف كل الأطراف لا طرف واحد.
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغرز بولاية نيوجرسي
القدس العربي
—————————-
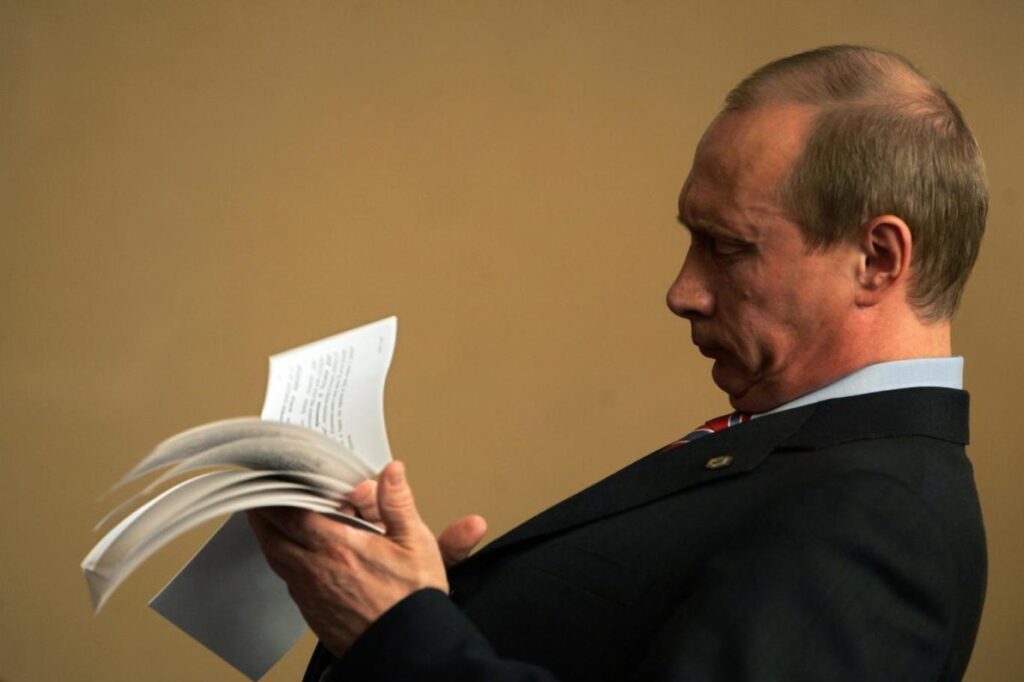
بوتين والغرب الأطلسي: هل يُعذر قيصر أنذرهم مراراً؟/ صبحي حديدي
لم يعد في البيت الأبيض رئيس أمريكي يدعى باراك أوباما، كي يفرك يديه ابتهاجاً بتوريط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستنقع الروسي؛ ولا رئيس خَلَف له يدعى دونالد ترامب، كي يغازل بوتين إلى درجة تسفيه الاستخبارات الأمريكية لصالح تأكيد مصداقية الكرملين؛ والذي في البيت الأبيض اليوم، جو بايدن، توهّم تسعير جولات جديدة من الحرب الباردة مع روسيا عبر مناوشات سيبرانية وتنويع العقوبات الاقتصادية، وتغافل (إذْ لا يعقل أنه، وهو رئيس القوّة الكونية الأعظم، قد غفل أو جهل) أنّ ما جمعته عواصف تفكيك الاتحاد السوفييتي في جعبة بوتين، القيصري النزوع والإمبراطوري الأهواء، يصعب أن تذروه رياح خفيفة عابرة، في جورجيا أو شبه جزيرة القرم أو سوريا، فكيف بألعاب الهواة في الحلف الأطلسي على الحدود الأوكرانية ـ الروسية.
في عبارة أخرى، ومنذ أن قبض على مقاليد السلطة في روسيا ما بعد بوريس يلتسين، ثمّ أحكم القبضة عبر مسرحية تبادل الرئاسة مع تابعه ديمتري مدفيديف، وصولاً إلى تنظيم استفتاء يبقيه في هرم السلطة الأعلى حتى عام 2036؛ لم يتكلف بوتين عناء تمويه مقاصده في توطيد مواقع روسيا الجيو-سياسة على الخريطة العالمية: عبر التدخل العسكري المباشر في كوسوفو وجورجيا والقرم وسوريا وأوكرانيا اليوم، وغير المباشر (في استخدام مرتزقة «فاغنر») حيثما توجّب ذلك في أربع رياح الأرض؛ فضلاً عن اختراق الأنظمة المعلوماتية هنا وهناك، ابتداء من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورعاية الفساد والاستبداد أينما اقتضت مصالح روسيا، ولا غضاضة في غمرة هذه الخيارات وسواها أن تلقى المافيات الروسية ما تحتاج إليه من عناية استخباراتية وأمنية وتشريعية…
وليس جديداً أن يُشار إلى تمتّع بوتين بشعبية لا يُستهان بها في الأوساط الروسية الشعبوية، أو تلك القوموية (بمعنى النزوعات المتشددة والانعزالية) وفئات الانصياع الأعمى لخطّ الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية (كما يدري وضعه، في أذهان هؤلاء، ضمن مواجهة مستعصية مع الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية)؛ ولن يكون جديداً، بالتالي، التفاف شرائح واسعة من الروس خارج هذه الفئات (مثل بقايا الشيوعيين السوفييت، اللينيين والستالينيين على حدّ سواء) خلف الحرب التي يزمع بوتين إشعالها في أوكرانيا، من منطلقات نوستالجية لا تبدأ فقط من الإمبراطورة كاترين أواسط القرن الثامن عشر، ولا تنتهي عند إعادة تعمير مناطق واسعة في أوكرانيا بإشراف رفيق سوفييتي يدعى ليونيد بريجنيف في أعقاب الحرب العالمية الثانية. قد يختلف هؤلاء مع بوتين وأجهزته في كلّ ما يتصل بالعيش والضنك الاجتماعي والاقتصادي والحريات السياسية ومافيات الفساد، وقد يهتفون ضدّه في التظاهرات التي يحرّكها سياسي صريح المعارضة مثل ألكسي نافالني؛ لكنهم اليوم سعداء بما يفعل بوتين في أوكرانيا، ومؤيدون له، بل لعلّ بعضهم يهتف بحياة ستالين (الذي ينسب إليه التاريخ المسؤولية عن فناء قرابة 3,9 مليون فلاح أوكراني) في ذروة الحماس لمعاقبة كييف.
وفي الخلفية الاجتماعية ـ الإيديولوجية، كانت وما تزال تحتدم في روسيا معركة داخلية حامية الوطيس، عابرة للتلاوين السياسية والتنظيمية، وقادرة حتى على تحييد صراعات الفساد واقتسام الثروات وشبكات الولاء؛ تدور بين استقطابين عملاقين تتمحور من حولهما وتلتقي فيهما، أو على النقيض منهما، جملة التيارات الليبرالية الكلاسيكية والـ»نيو ـ ليبرالية» والشيوعية والاشتراكية الإصلاحية و«اشتراكية السوق» والنزعات القومية المعتدلة أو تلك المتطرفة. وكانت المعركة تصنع كلّ يوم، وتُبلور أكثر فأكثر، تيّارين مركزيين باتا جزءاً لا يتجزأ من الفسيفساء المعقدة التي رسمت قسمات روسيا ما بعد الحرب الباردة: الاستقطاب الاستغرابي (نسبة إلى الغرب والتواريخ المشتركة والأواصر الثقافية والدينية مع روسيا القياصرة)؛ والاستقطاب الأورو ـ آسيوي (نسبة إلى موقع روسيا الفريد على التخوم الحاسمة لقارّتين شهدتا وتشهدان أعمق الصراعات الحضارية على مرّ التاريخ). وهذا سجال يعود إلى القرن السابع عشر زمن القيصر بطرس الأكبر، لكنه لا يكفّ عن احتلال أفئدة الروس، قبل عقولهم في الواقع، كلما اندلع نزاع يمسّ هوية روسيا وشخصيتها الحضارية والتاريخية؛ كما هي الحال هذه الأيام، بصدد أوكرانيا والغرب والحلف الأطلسي.
ليس مدهشاً، في المقابل، أن يجد بوتين شرائح مناصرة له في قلب مجتمعات غربية ولدى ساسة في أنظمة ديمقراطية، على غرار ما يتمتع به من تأييد لدى ثلاثة على الأقلّ من المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا العام: زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين، الزعيم الجديد لليمين العنصري الفاشي إريك زيمور، وزعيم تيار «فرنسا الأبية» اليساري جان – لوك ملنشون. أسبابهم تتفاوت بالطبع، غير أنّ المرء لا يعدم ذريعة «السيادة الوطنية» لدى الأولى، والكنيسة المسيحية لدى الثاني، ومقارعة الإمبريالية لدى الثالث. بعض أوساط اليسار الأمريكي تعتمد، بدورها، الذريعة الأخيرة الأردأ من حيث التغطية الإيديولوجية العامة والتعميمية؛ لكنها، عند تبرير جرائم بوتين في جورجيا والقرم وسوريا وأوكرانيا، تفعّل مكاسب محاربة «الإرهاب» كما تزعم أنّ التدخل العسكري الروسي حقّقها تارة، أو التمييز تارة أخرى بين حقّ تقرير المصير مقابل وحدة الأراضي الوطنية، على غرار منطقتَيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين اللتين اعترف بوتين باستقلالهما عن أوكرانيا.
ليس أقلّ جدارة بالتذكير سابقة الشيشان، وتلك بدورها كانت جولة اجتياح بدأ بتدخل خارجي، مع فارق أنّ واشنطن وغالبية أعضاء الحلف الأطلسي كانوا، ساعة الغزو بالضبط، يحتفلون بالرئيس الروسي الأسبق يلتسين، ضيفاً عزيزاً مكرّماً في قمة هاليفاكس لعمالقة الكون السبعة. من جانبها كانت تقارير الصليب الأحمر الدولي تفيد، رسمياً، بعدم وجود أي أسير شيشاني في قبضة الجيش الروسي، ليس لأيّ اعتبار آخر سوى أنّ هذا الجيش لا يعترف بتسمية كهذه! أمّا في ميادين الاجتياح، فقد كان الجيش الروسي يعيد إنتاج حلقات العنف ذاتها التي حكمت علاقة السلطة المركزية الروسية بالشيشان طيلة عقد التسعينيات؛ الأمر الذي سوف يُعاد إنتاجه، أكثر وحشية وعنفاً، على يد بوتين وجنرالاته، أواخر القرن المنصرم.
وقبل وقت غير بعيد توفّر تصريح شهير، عالي البلاغة والجسارة، يصف أوضاع الرئاسة الروسية هكذا: «رائحة احتضار الكرملين، ممتزجة بجنون سيّده، تفوح من هذه القرارات العجيبة» قال بوريس نمتسوف الذي كان قبيل التصريح عضواً بارزاً في «الحلقة الإصلاحية» الضيّقة المحيطة بشخص يلتسين إحاطة السوار بالمعصم. قبله كان غينادي زيوغانوف، زعيم الحزب الشيوعي الروسي ورئيس كتلته في الدوما، قد اقتبس فيودور دستويفسكي ليصف الكرملين: «ستّة رؤساء وزارة في 18 شهراً… ألسنا بالفعل في بيت مجانين؟». ليس تماماً، إذا شاء المرء الركون إلى حدّ أدنى من الإنصاف، وليس أيضاً لأنّ حزب زيوغانوف بارك اعتراف بوتين بالانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك، وانضمّ بالتالي إلى ركب سياسات بوتين الأوكرانية، بل اعتنق حرفياً خطاب الكرملين الرسمي الذي يقول إنّ سبب الأزمة الراهنة هو عزم «القوى الفاشية» في كييف على تنظيم مذبحة في منطقة دونباس بحقّ المواطنين الروس هناك.
لا هو بيت مجانين، إذن، ولا سيّده بمجنون؛ والأحرى، بل الأبسط في الواقع، هو استذكار العنصر الذي قد يكون الأبرز في عقلية بوتين الجيو ـ سياسية، وفي البنية الطاغية على مركّب شخصيته النفسية، أي النزوع الإمبراطوري/ القيصري إلى إحياء روسيا العظمى. ليس كيفما اتفق، للإنصاف هنا أيضاً، بل لأنّ جرائم سيّد الكرملين في كوسوفو والشيشان وجورجيا وشبه جزيرة القرم وسوريا وأوكرانيا ارتُكبت عن سابق قصد وتصميم؛ حتى أنّ التساؤل المشروع يقول: خلال جولاته مع الغرب الأطلسي، هل يُعذر قيصر أنذرهم، مراراً وتكراراً!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
—————————-
أوكرانيا: حرب من القرن الماضي بتوقيت غوغل!
شرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب طويل الاثنين الماضي، أن أوكرانيا ليست سوى جزء تاريخي وجغرافي من روسيا.
قدّم الخطاب أيضا عناصر «مظلومية» تاريخية روسيّة منها نسبة تشكيل أوكرانيا نفسها إلى روسيا، وانفصال الجمهوريات السوفييتية السابقة بعد انهيار الاتحاد، كما قدّم تصوّره لسلسلة من الأحداث يحمّل فيها النخب السياسية الأوكرانية، بعد ثورة 2014 الشعبية مسؤولية تنكّرها لكرم روسيا المستمر، و«انهيار الاقتصاد» والفساد، وارتكاب فظائع، وكبت حرية التعبير، والعمالة للأجانب الغربيين، ودعم «التنظيمات الإسلامية المتطرفة» والتخطيط لحيازة سلاح نووي.
يعيد بوتين تركيب الأحداث التاريخية بقصد «تصحيح» الماضي، والانتقام لمظلومية، ويرسم وقائع شديدة التناقض والتنافر بطريقة الأبيض والأسود بحيث يحقّ للقومية الروسيّة استعادة ما كان لها، فيما يعتبر الطموح القومي الأوكراني «نازية» وهو ما لخّصه كاريكاتور أوكراني بإظهار الزعيم الألماني أدولف هتلر وهو يرحّب ببوتين.
على الطريقة التي تمتّ إلى أدبيات الدعاية السياسية «البروباغاندا» الموروثة من القرن الماضي، قام الإعلام الرسمي الروسيّ بالتعامل مع الحدث الأوكراني، بداية، مع قرار نقل سكان المناطق الشرقيّة الأوكرانية باتجاه روسيا، والحديث عن «إبادة جماعية» تقوم بها أوكرانيا للروس، وإظهار أن ما يحصل هناك هو اعتداء تقوم به أوكرانيا وليس تحشيدا عسكريا روسيا يتجهز للانقضاض على البلد المجاور.
في خطابه الأخير، أمس الخميس، الذي أعلن بوتين فيه الحرب على أوكرانيا مسميا ذلك «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح الدولة الأوكرانية، والقضاء على «النازيين» ظهر بوتين على الطاولة نفسها وبالبدلة نفسها التي ألقى فيها خطاب يوم الاثنين، كما أن تدقيق الخبراء الالكترونيين في شرائط الفيديو التي نشرها الإعلام الروسي لطلب القادة الانفصاليين الدعم من روسيا الأربعاء 23 شباط/فبراير، أظهر أن التواقيع كانت من اليوم الذي سبقه.
من المثير أيضا أن الجهة التي كشفت بدء الحرب كان محرّك البحث العملاق «غوغل» الذي أظهر تحرّكات أرتال عسكرية بخطوط حمر تشير إلى «تكدس مروري» وقد تزايدت هذه الخطوط الحمر مع تزايد قوافل النازحين واللاجئين الهاربين من كييف إلى الغرب، أو المتجهين إلى بولندا ودول الجوار.
ما لبثت المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أن بدأت، من كل مكان، بنقل وقائع الحرب لحظة بلحظة، فرأى المتابعون طفلا في فندق في مدينة خاركيف يعزف البيانو فيما تدخل الدبابات الروسية إلى المدينة، وأظهر شريط فيديو لأحد حراس الحدود الأوكرانيين عربات عسكريات روسية تدخل البلاد من شبه جزيرة القرم، وتابع آخرون نشر فيديوهات تظهر دخانا متطايرا وحرائق بعد وقوع الهجمات مباشرة، وبدأ إعلاميون روس ونشطاء بوضع إشارة مربع أسود للتدليل على رفضهم للحرب.
رغم محاولة السلطات الروسية السيطرة على الواقع الافتراضي عبر حرب سيبرانية مرافقة للغزو العسكري التقليدي لأوكرانيا، فإن أجهزة التصوير في الهواتف المحمولة، والمواقع الالكترونية، والأقمار الصناعية، والأشخاص العاديين الذين يشاركون من كل مكان عمليا في نقل الأحداث والتعليق عليها، يخلق مفارقة كبيرة بين هجوم يبدو استكمالا للحربين العالميتين في القرن الماضي، وبين مشاركة الملايين في تلك الحرب من خلال الوسائل الحديثة التي قدمها الانترنت وتقنيات الهاتف المحمول.
الأمر المتوقع هو أن الحرب ستجر معها الكثير من الخراب والآلام ونزف الدماء، لكن نتائج اصطدام أوهام الماضي بوقائع الحاضر سيكون من الصعب توقعها.
القدس العربي
———————————-

بوليتكو: إدارة بايدن لم تفهم طريقة تفكير بوتين واعتقدت أنها ستغير سلوكه بالعقوبات والدبلوماسية
إبراهيم درويش
نشرموقع “بوليتكو” تحليلا لناحال توسي قالت فيه إن الرئيس جوي بايدن وفريقه اعتقدوا أنهم يستطيعون التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن حساباتهم كانت خاطئة بشكل قاتل. وقالت إن الرئيس جوي بايدن لم يخف على مدى العقدين الماضيين مقته وعدم ثقته بالرئيس بوتين، بل وزعم مرة أن الأخير لا روح له. لكن بايدن حاول منذ العام الماضي التعامل بعقلانية مع بوتين ذو العينين الفولاذيتين. وعندما التقى بايدن ببوتين في جنيف في حزيران/يونيو نصحه بوقف عدوانه على أوكرانيا والتوقف عن الهجمات الإلكترونية لأن هذه يضر “بمصداقيته الدولية”.
وفي كانون الأول/ديسمبر عندما كان بوتين يحشد قواته على الحدود الأوكرانية التي غزاها في عام 2014، دفعه بايدن بخفض التوتر و “العودة للمسار الدبلوماسي”. وفي بداية الشهر الحالي حذره من غزو أوكرانيا لأنه “سيؤدي لمعاناة إنسانية واسعة ويشوه موقف روسيا”. ولم تنفع كل هذه المحاولات لأن بوتين أثبت بغزوه أوكرانيا يوم الخميس أنه يتعامل مع العالم ومصالحه بطريقة مختلفة، وبدا عصيا على كل وسائل الدبلوماسية التقليدية والردع. ولم تنفع مناشدات بايدن لذات بوتين الجيوسياسية: لا التهديد بالعقوبات ونشر قوات في دول حلف الناتو أو دعم أوكرانيا بالأسلحة ولا المناشدات العاطفية وانتشار المعاناة الإنسانية، الشجب ولا حتى تماسك المواقف بين أمريكا وحلفائها.
كما ولم ينجح أسلوب إدارة بايدن بنشر ما تعرفه من معلومات أمنية عن خطط وتحركات روسيا. ولم ينشر بايدن قوات في أوكرانيا والتي كانت كفيلة بتغيير خطط بوتين. وبالنسبة لبايدن وفريقه، فقد كان الغزو لحظة إحباط عميقة. فقد فشلت إدارة بايدن في استراتيجية منع الغزو حتى عندما تكيفت مع مواقف بوتين العنيدة.
ومن هنا فالهجوم على أوكرانيا يحمل مخاطر حرب واسعة في أوروبا وتحمل كل العلامات السيئة للإدارة التي ستحد من قدرتها للتركيز على أولوياتها الاخرى وتحديدا، ما تمثله الصين من تحد. وزاد بايدن يوم الخميس من جهوده وفرض عقوبات واسعة على روسيا ونشر مزيدا من القوات في مناطق الناتو ووعد بمضاعفة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على وحدة الحلفاء. وحذر من الثمن الفادح الذي ستدفعه روسيا بهجومها على أوكرانيا “وسنتأكد من تحول بوتين إلى منبوذ على المسرح الدولي”. ونفى بايدن أنه لا يعرف تفكير بوتين بالكامل “لم أقلل ابدا منه”، إلا أن أنصار الرئيس الأشداء يخالفونه في هذا الرأي.
فعندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض أعلن وفريقه عن رغبة بعلاقة “مستقرة” مع موسكو والتعامل في قضايا الأسلحة النووية والتغيرات المناخية والإختلاف معها عندما لا تتوافق مصالح البلدين. وكجزء من استراتيجية الإدارة عن روسيا، فرضت عقوبات عليها لتدخلها السابق في الإنتخابات الأمريكية وأعلنت عن قمة بين بايدن وبوتين، مع تأكيدها على أن الأولوية الكبرى لأمريكا في عهد بايدن ستكون الصين. وقرر بايدن تخفيف العقوبات على ألمانيا وروسيا بسبب خط الغاز نورد ستريم2 وهو ما فسره الصقور بأنه ضعف امام بوتين. وخشي الكثير من العاملين في إدارة بايدن، وعدد منهم جاءوا من إدارة باراك أوباما أن الرئيس وفريقه ساذجين. ففي إدارة أوباما بدأ بوتين باستخدام طرقه الخفية وضم القرم عام 2014، لكن أوباما وفريقه لم يعرفوا المدى الذي سيذهبون فيه لتصعيد المواجهة مع روسيا وقاوموا فكرة إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
وحذر المراقبون للشأن الروسي إدارة بايدن من فكرة قدرتها على التحكم ببايدن والتعامل الدبلوماسي بناء على فكرة “واحدة بواحدة”. وفي العام الماضي نقل الموقع عن السفير الأمريكي السابق في موسكو مايكل ماكفول، الذي علق على حزمة العقوبات التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية عقابا لروسيا على تصرفاتها السابقة على أمل أن تكون الأخيرة، قوله: “أشك بأنه بوتين سيمضي مع هذا الإستراتيجية” و “أحبوا أم كرهوا، فبوتين سيكون جزءا من سياسة بايدن الخارجية في السنوات الأربع المقبلة”.
وفي الحقيقة لم تختف روسيا من عناوين الأخبار. وفي الربيع الماضي علق ماكفول عن حشد روسي على الحدود الروسية، مع أن هذا التحرك لم يقلق الإدارة. وفي نفس الوقت استمرت الهجمات السبرانية من الأراضي الروسية، بما فيها هجوم شل وبشكل مؤقت عمل أنبوب للطاقة مهم في أمريكا. وآخر استهدف بعد أسابيع من لقاء بايدن ببوتين عددا من الشركات الأمريكية. ولم تتجاهل إدارة بايدن هذه الهجمات ولكنها حاولت اللجوء إلى الدبلوماسية الهادئة وتحذير الروس وإصدار اتهامات ضد مجرمين سبرانيين لهم علاقة بها. ونجحت حيث سحبت روسيا الكثير من قواتها وتوقفت جماعة إلكترونية “أر إي فيل” عن العمل.
وفي الخريف الماضي بدأ بوتين بحشد قواته على الحدود مع أوكرانيا، وبأعداد مثيرة للقلق. وحثت الإدارة بوتين وبهدوء التراجع ثم بدأت بالحديث مباشرة مع روسيا وأشركت حلفاءها في اوروبا وغيرهم لإظهار الجبهة الموحدة ضد موسكو. ولم تكن مهمة سهلة، فقد خافت عدة دول أوروبية إغضاب روسيا بسبب اعتمادها على الطاقة. ولكن إدارة بايدن بدأت بنشر ما جمعته من معلومات استخباراتية عن التحركات الروسية لإظهار خطورة الوضع. كما ونشر بايدن مزيدا من القوات في أوروبا لمنع انتشار التهديد من أوكرانيا.
وكانت النتيجة، هي اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على حزمة واسعة من العقوبات جاهزة حالة غزا بوتين أوكرانيا، بل وانضمت دول آسيوية مثل اليابان إلى التحركات. وفي الوقت نفسه ظل المبعوثين الروس يتحدثون عن المسار الدبلوماسي للأزمة، مع أنهم حاولوا التضليل وكذبوا في مرات. ولو كان الردع هو الهدف، فقد فشل. وفي بداية الأسبوع اعترف بوتين بمناطق يتحكم بها الإنفصاليون ثم صعد بإرسال القوات إلى داخل أوكرانيا.
ويرى المسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون أن الإدارة لم يكن لديها ما يمكن عمله لوقف بوتين عن تحركاته، وبخاصة بعدما عبر عن نواياه، بل واعتبر أوكرانيا بلدا مزيفا. وهذا جزء من المبررات التي قدمها إضافة لمخاوفه من توسع الناتو. وفي نفس الوقت راقب بوتين الأنظمة، التي نجت من العقوبات الغربية مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، وأحيانا ساعدها. فهذه الأساليب عادة ما تقدم نتائج مزيجة، ومن غير المحتمل ألا تنجح مع روسيا. ويؤمن بوتين بالقوة الصلبة لتغير النظام الدولي. وتقول إيلين فاركاس، المسؤولة السابقة في البنتاغون “من الصعب مواجهة عقلية إمبريالية انتقامية” و “لا يستمع بوتين إلا للقوة وفي هذه المرحلة القوة العسكرية”. وقال هيذر كونلي، التي عملت في وزارة الخارجية أثناء إدارة جورج دبليو بوش إن فريق قام بعمل جيد لكنها تحسرت من أفعال بوتين. و “لعبت الإدارة بقواعد الدبلوماسية والتصعيد” “إلا أن بوتين لم يؤمن أبدا بهذه القواعد إلا في حالة قبول الغرب بمطالبه. ولست متأكدة من أن قبول الغرب لمطالبه كان سيمنع ما نراه اليوم”. وهناك البعض رأى أن تحركات ما كانت كفيلة بتغيير موقف بوتين مثل رؤية قوات أمريكية في أوكرانيا، إلا أن هذا مستبعد لموقف واضح من بايدن الذي لا يؤمن بتدخل الولايات المتحدة في الخارج.
وبعد وصول بايدن وفريقه إلى السلطة ورثوا سياسة خارجية مشتتة، بشكل عقد من مهمتهم. وحاول الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على خدمات من بوتين وعارض محاولات الكونغرس فرض عقوبات على روسيا. وقضت الإدارة الأشهر الأولى في الحكم لإصلاح العلاقات التي تدهورت مع ألمانيا وفرنسا. كما أن أي محاولة للضغط على روسيا كان كفيلا برفع أسعار الغاز والنفط وهو ما لم يكن بايدن يريده.
وتقول ألينا بولياكوفا، من مركز تحليل السياسات الاوروبية “كانت هناك مخاطرة لمنح أولوية (لأوكرانيا) على حساب السياسة المحلية، وأحترمهم لهذا القرار” و “يتخذ القرار الصائب وسيكلفه كثيرا” عن بايدن. وفي الوقت الحالي يشعر بوتين بأن الوقت معه، فهو يخطط للبقاء في السلطة بعد خروج بايدن، وأن الجبهة الحالية في أوروبا قد تتداعى عندما تشعر بضغط العقوبات عليها. ويعني استمرار الازمة الأوكرانية صعوبة التركيز على التحديات الدولية الأخرى مثل الصين. ويزعم المسؤولون الأمريكيون أنهم قادرون على التعامل مع أزمتين، أي روسيا والصين، إلا أن توسع العنف في أوكرانيا إلى أوروبا فلن تكون واشنطن قادرة على احتواء أزمة مستمرة علاوة للتركيز على الصين.
———————–
أوكرانيا بوابة لسياسة صينية جديدة/ مهند الحاج علي
بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا وتبعاته في السياسة الدولية، تتجه عيون كثيرة إلى تايوان الشبيهة في حالتها كمحمية غربية ما زالت تابعة سيادياً للصين، مثلها مثل هونغ كونغ. ذاك أن امتحان هذه الحرب الروسية، وحجم الرد الغربي عليها، عسكرياً واقتصادياً، وجديته، قد ينعكس على مقاربة الصين التحديات الأمنية الشائكة في جنوب شرقي آسيا، وتحديداً تايوان.
لكن ما هو الموقف الصيني وكيف قد يتطور مع تطور الأزمة؟
تُحاول الصين في سياستها الخارجية التركيز على مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية للدول، لهذا وحين حصل الغزو الروسي لأوكرانيا، ركزت الإدارة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون على هذه المقاربة وأسسها لإحراج بكين أو حضها على موقف مُغاير. مثلاً، ألمح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى هذا المبدأ، متحدثاً عن “فرصة” لاستخدام الصين نفوذها مع روسيا لوقف الغزو.
ولكن أيضاً، لدى بكين اهتمام بعدم الدخول في صدام مع أوروبا والولايات المتحدة، وفي الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. وبالتالي فإن موقفها من الغزو الروسي سيُحتم عليها الخروج عن المألوف في مقاربة السياسة الخارجية، علاوة على احراجها في العلاقة مع شركائها التجاريين. الصين الشريكة التجارية الأولى لأوكرانيا منذ عام 2019، وحلت مكان الاتحاد الروسي، وبلغ حجم التبادل التجاري 19 مليار دولار أميركي العام الماضي، علاوة على أخذها قروضاً صينية لتعزيز البنى التحتية للبلاد.
والمفارقة أن الرئيس الأوكراني الحالي فلوديمير زيلينسكي كان يُعوّل على هذه العلاقة والشراكة الاستراتيجية مع الصين، وطالب نظيره الصيني بأن تكون أوكرانيا جسراً لعالم الأعمال الصيني الى أوروبا.
لكن رفض الصين توصيف الغزو الروسي باسمه، ودفاعها عن موسكو وهجومها على القوى الغربية، لن يترك مجالاً لعلاقات استراتيجية مع أوكرانيا مستقبلاً، في حال عودة السيادة لاحقاً. وعدم محاولة الصين إيجاد توازن بين روسيا، من جهة، وبين شركائها التجاريين الكبار في أوروبا والولايات المتحدة، من جهة ثانية، قد يحمل انعكاسات اقتصادية، سيما أن إدارة الرئيس جو بايدن تضع احتواء الصين في صلب أولوياتها للسياسة الخارجية.
ولكن هناك أيضاً في التجربة الروسية اليوم، دروساً مستقبلية للصين. كم سيكون تأثير العقوبات الغربية في روسيا؟ وكيف ستنعكس محاولات عزل روسيا على العلاقات بين بكين وموسكو في ظل اعتماد متزايد عليها، تماماً كما حصل مع ايران خلال فترة حملة الضغوط القصوى الأميركية. كانت ايران خلال السنوات الماضية تعتمد على التعامل مع الصين، نفطياً، كحبل نجاة من العقوبات، وبالتالي علينا توقع اعتماد روسي أكبر على بكين، وربما تقارب وتنسيق مختلفين نوعياً.
في المحصلة، الأرجح أن لا تغزو الصين تايوان لأسباب على ارتباط بحاجتها لمواصلة النمو اقتصادياً وتعزيز علاقاتها التجارية مع العالم. ومثل هذه المقاربة لا تستوي مع عقوبات ومواجهة عسكرية. لا حاجة لذلك الآن. لكن الأهم من تايوان أننا أمام تشكل تحالف لصيق بالصين وأكثر اعتماداً عليها، اقتصادياً وسياسياً، وأمام خيارات مغايرة بالسياسة الخارجية الصينية (مهاجمة الغرب والتقارب مع روسيا، مقارنة بموقفها المحايد من حربها في جورجيا عام 2008).
وهذا الفرز السياسي بين القوى المختلفة مع العنف المرافق له، يجترح عالماً جديداً بتوازنات مختلفة وقد تصلنا ارتداداته في هذه المنطقة المنهكة والمثقلة بالنزاعات، أسرع مما نعتقد.
المدن
————————–
حين يصحح بوتين أخطاء لينين/ ساطع نور الدين
الفارق بسيط بين ان يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد إجتاح اوكرانيا لكي يصفي حسابه مع لينين وستالين ويصحح الأخطاء السوفياتية الاولى، أو لكي يحذو حذو هتلر الذي أشعل حرباً عالمية إنتقاما من الذين هزموا المانيا في الحرب العالمية الاولى؟
الفرصة سانحة والظرف مناسب لكلا الاحتمالين، لكن “الحتمية التاريخية” التي يناقضها بوتين ويعمل ضدها، لن تؤدي إلا الى النتيجة التي توخاها لينين، قبل أكثر من مائة عام، والتي ذهب ضحيتها هتلر بعده بأقل من ثلاثين سنة.
ما زال الرئيس الروسي الراهن مقيماً هناك، ينتمي الى النصف الاول من القرن الماضي. وهذا ما يؤكده ويشرحه بنفسه وبالتفصيل الممل في جميع خطاباته وتصريحاته المطولة، لاسيما خطابه التلفزيوني الاخير مساء الاربعاء الذي كاد يتلبس فيه شيطان الزعيم النازي، عندما إختتم كلامه بالقول: “عسى أن يكون الجميع قد سمع ما قلته جيدا”.
لن تخرج أوكرانيا من الغزو الروسي كدولة مستقلة، ذات سيادة. وقد لا تبقى دولة موحدة. لن يتوقف بوتين قبل ان يحقق لائحة أهدافه الاوكرانية المحددة، والتي تعيد الى الاذهان ذكريات حروب القرن الماضي، وهي تبدأ من نزع سلاح الدولة الاوكرانية واسقاط حكم النازيين الجدد في كييف، واعلان الحياد التام لاوكرانيا..وصولا الى الهدف غير المعلن وهي ضم الاراضي الأوكرانية، التي يجري تحريرها الآن، الى روسيا مجدداً ، كما كان عليه الحال قبل الثورة الشيوعية عندما كانت أوكرانيا ريفاً روسياً وشعبها في خدمة القياصرة الروس.
وهو مخطط سهل جدا. يمكن إنجازه خلال ايام او اسابيع لا أكثر، ليس بسبب عدم تكافؤ موازين القوى العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل بسبب عدم تكافؤ ميزان العصبية الوطنية التي تحرك البلدين والشعبين، وعدم تفاعل الغرب، أو حتى تورطه في الغزو الروسي، الذي علِم حلف شمال الاطلسي بتفاصيله ، قبل ان يطلع عليه الروس أنفسهم..وهو ما يوحي بأن الحلف الذي تصدع وكان على وشك حلّ نفسه في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، لم يعد يتمتع بترف الانجرار الى حرب باردة جديدة مع الكرملين، ومن أجل بلد كان بمثابة حديقة خلفية لروسيا.
لكن بوتين، على الاقل في الاسابيع الاولى من الغزو، لن يسمح لحلف شمالي الاطلسي بتفادي استدراجه الى حرب بادرة جديدة، ولن يسلم بان يستخدم الحلف سلاح العقوبات السياسي والاقتصادي الجارح ، من دون رد عسكري قاس، خارج الحدود اوكرانيا التي يسارع للسيطرة عليه وتغيير خريطتها السياسية وهويتها الوطنية. على جدول اعمال الكرملين أهداف أخرى، ودول عديدة تمردت على الهيمنة الروسية، وأنزاحت نحو الغرب، تترقب دخول القوات الروسية الطامحة الى استعادة الجغرافيا السوفياتية، من دون النظرية الشيوعية.
دفاعاً عن هذه الدول، سيضطر حلف الاطلسي الى القتال، بغير سلاح العقوبات وحده، وسيحاول أن يتحدى الانذار الصريح الذي وجهه بوتين في خطاب الغزو مساء الاربعاء. لكن الدافع الغربي الى تلك المعركة سيكون أضعف بما لا يقاس من دوافع الروس لاستعادة أمجادهم الامبراطورية الماضية، وللسير خلف زعيمهم الحالي الذي إنتشلهم، حرفيا، من الجوع والفقر والذل، ولو بواسطة أجهزة أمنية وعسكرية نموذجية في إستبدادها وفي سمعتها العالمية المشينة، وفي تحالفاتها المخزية التي يتقدمها الطاغية البيلوروسي الكسندر لوكاتشينكو، والسوري بشار الاسد..
لهذه الحملة العسكرية الروسية التي تشبه حملات القياصرة في القرن التاسع عشر، ثمن باهظ على الاوكرانيين وحدهم، دون سواهم، وعلى آخرين من شعوب دول الشرق الاوروبي التي سيجتاحها بوتين لاحقاً، ويدافع عنها الغرب ببيانات شديدة اللهجة: الحفاظ على الهوية الاوكرانية يتطلب من الآن فصاعداً الرهان على حركة مقاومة شعبية للاحتلال الروسي الذي جاء ليبقى، وليغير معالم الدولة ورموز الحكم في ذلك البلد الفقير والمعذب طوال عمره القصير.
—————————–

الشتاء الطويل على الأبواب: ماذا وراء اجتياح روسيا لأوكرانيا؟/ فيكين شيتريان
قد يكون لدى روسيا مخاوف أمنية مشروعة تجاه الناتو، لكن هل هناك قانون على الأرض يحرم أوكرانيا والأوكرانيين من حقهم المشروع في الأمن والكرامة والاستقلال؟
في 24 شباط/فبراير 2022، غزا الجيش الروسي أوكرانيا. لم يعد بالإمكان أن تعود العلاقات الدولية كما كانت مرة أخرى. ونظراً لأن الجيش الروسي يستهدف كامل أراضي أوكرانيا، فإن هدفه السياسي يظل غير محدد.
ما الهدف السياسي من وراء الغزو الروسي لأوكرانيا؟
توضح الاستعدادات العسكرية الطويلة وحجم العمليات أن الأهداف الروسية لا تقتصر على الجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك. ولفهم ما تخطط روسيا لتحقيقه من وراء هذا الغزو، يجب على المرء العودة إلى خطاب بوتين في 21 شباط/فبراير، الذي أنكر فيه حق أوكرانيا في سيادة الدولة. وعليه، فإن الهدف من الغزو هو إحداث تغيير في النظام من خلال الغزو العسكري، وإخضاع أوكرانيا للسيطرة الروسية.
لن تعود العلاقات الدولية كما كانت مرة أخرى؛ فالعمليات العسكرية الروسية لا يمكن مقارنتها بتلك التي حدثت في عام 2014؛ عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وخلفت وراءها حالة حرب دائمة في دونباس. ولا يمكننا مقارنة الغزو الحالي بالحرب الروسية الجورجية في عام 2008، عندما كان بإمكان الجيش الروسي التقدم إلى تبليسي وإسقاط ميخائيل ساكاشفيلي، لكنه امتنع عن ذلك. اليوم، يأتي الغزو الروسي لأوكرانيا بهدف الهيمنة الكاملة. إنه مشابه للغزو الأميركي للعراق عام 2003، بنتائجه الكارثية المعروفة.
لتحليل الأزمة الحالية، من الضروري التمييز بين مستويين من الصراع: العلاقات الروسية الأميركية، والعلاقات الروسية الأوكرانية. الصراع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة “خطأين أصليين”، وليس خطيئة واحدة.
الأول هو القرار الأميركي إبان حكم الديمقراطي بيل كلينتون في عام 1993 الذي لم يكتفِ بالحفاظ على قوات حلف الناتو، ذلك التحالف العسكري الذي تشكل ابتداءً ليكون رأساً برأس مع الاتحاد السوفيتي، بل توسعة نطاق وجوده شرقاً. كانت البدائل الأخرى، مثل تفكيك الناتو، وإيجاد بنية أمنية مشتركة في أوروبا تستوعب روسيا، عرضة للتجاهل. وفي مرحلة ما، كان على هذا التوسع العسكري اللامتناهي باتجاه الشرق أن يصطدم بالمقاومة الروسية.
لكن لماذا الآن؟
لأن روسيا تشعر بالاطمئنان الذاتي بعد إصلاحاتها العسكرية الهائلة منذ عام 2008، وحملاتها العسكرية “الناجحة” في الشيشان وجورجيا وسوريا وليبيا وأماكن أخرى، وأيضاً لأن روسيا بجيشها البالغ مليون جندي لديها قوة عسكرية لها وزنها على المسرح الأوروبي.
على أحد المستويات، فإن هذا الصراع يمثل حديثَ قوة عظمى إلى قوة عظمى أخرى؛ فعندما أعلن بوتين مطالبه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 بتراجع قوات الناتو إلى حدود 1997، لم يوجه هذه المطالب إلى كييف ولا إلى بروكسل، بل إلى واشنطن. يوجه بوتين حديثه لبايدن بلغة القوى المهيمنة نفسها بإرجاع الحدود الجيوسياسية لأوروبا الشرقية، وذلك ببساطة لأن روسيا اليوم لديها الوسائل للقيام بذلك بنفسها، تماماً مثلما كان التصرف الأميركي في التسعينيات.
لكن ثمة مستوى آخر من التحليل، وهو مستوى العلاقات الروسية الأوكرانية؛ وهنا ارتكبت روسيا “الخطيئة الأصلية” الثانية في عام 2014 في سياق ثورة “الميدان الأوروبي”.
أوكرانيا دولة شاسعة، لكنها هشة؛ فكلٌ من تكوينها الداخلي، المكون من عدد كبير من السكان الناطقين بالروسية في شرقها وجنوبها، وسكان مؤيدين للغرب في غاليسيا، وأيضاً وضعها الجغرافي السياسي بين روسيا من جانب وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، كل ذلك أجبر أوكرانيا على التصرف كما لو كانت تتأرجح على حبل رفيع من أجل تحقيق التوازن. لقد رأينا بالفعل هذا التصرف المتأرجِح في عام 2004، عندما عاد المرشح الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إلى السلطة بعد “الثورة البرتقالية”.
وحتى بعد أحداث الميدان الأوروبي، كانت إمكانية إعادة التوازن بين روسيا والغرب قائمة، إلى أن ذهبت هذه الإمكانية أدراج الرياح بضم روسيا لشبه جزيرة القرم والحرب في دونباس. بعد عام 2014، لم يتمكن أي زعيم أوكراني من المساومة مع روسيا، بل كان عليهم إظهار مواقف مؤيدة لروسيا. دفعت الإجراءات الروسية أوكرانيا نحو أحضان الغرب، وعززت سياستها الداخلية تجاه القومية التي تُعرَّف بأنها مناهضة لروسيا.
الغزو الذي نشهده اليوم سيعزز الهوية الوطنية الأوكرانية بالمصطلحات القومية، وهو ما سيمثل قطيعة نهائية بين الهويتين الأوكرانية والروسية. هذه عملية مؤلمة بدأت في عام 2014، وسوف تمزق النسيج الاجتماعي، ليس فقط لأوكرانيا، بل لروسيا أيضاً.
إقرأوا أيضاً:
انعدام الأمن الأوروبي
يبقى أن نرى ما إذا كان بوتين سينجح في الحصول على ما يريد من أوكرانيا بهذا الغزو العسكري. إلا أن ما يتعلق بعلاقاته مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوروبا سينتهي بكارثة. كشفت الأزمة الأوكرانية في الأشهر القليلة الماضية عن “الغرب” المنقسم للغاية؛ فالولايات المتحدة منشغلة بمكان آخر، منطقة المحيط الهادئ والمشاكل السياسية الداخلية، وغير مستعدة لمواجهة روسيا في أوكرانيا.
كما أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي توقع أكثر من مرة الغزو الروسي القادم، أن الولايات المتحدة لم تكن لترسل جنودها للدفاع عن أوكرانيا. أما في أوروبا، فهناك دول متاخمة لروسيا، مثل بولندا ودول البلطيق، وخوفًا من عودة ظهور روسيا، كانت لها مواقف تقليدية متشددة ضد موسكو. لكن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أرادت علاقات طبيعية، وحل المخاوف الأمنية الروسية من خلال الدبلوماسية. وهذه الطريق الثالثة قُطِعت الآن.
الغزو العسكري الروسي في 24 شباط/فبراير هو نهاية جهود ماكرون وشولتز. روسيا، بعد تجميد القومية الأوكرانية، ستجمد الناتو على حدودها. من مستوى تاريخي منخفض يبلغ 70 ألف جندي، قد تعيد الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية جديدة في أوروبا.
على صعيد آخر؛ تخشى دول الاتحاد الأوروبي أن تزيد روسيا إنفاقها العسكري. ونظراً إلى أن الصراع الحالي قد يدفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث عن بدائل للطاقة الروسية، كما سيفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على روسيا. وإذا كان لدى موسكو باحتياطياتها التي تزيد عن 600 مليار دولار، الوسائل لمقاومة الضغوط المالية، فلن يكون لدينا شك بشأن التأثير الكارثي للحرب والعقوبات على الاقتصاد العالمي الذي أصيب بالشلل الشديد بعد عامين من الجائحة.
لكن أوكرانيا والشعب الأوكراني هم أكثر من سيعاني.
أوكرانيا هي واحدة من أكثر الدول مأساوية في أوروبا، وقد عانت بشدة عبر تاريخها. لقد وُلدت دولةً مستقلة من رحم أهوال الحرب العالمية الأولى، تلتها الحرب الأهلية الروسية التي راح ضحيتها الملايين.
أثناء سياسة تأميم أراضي الفلاحين والزراعة الجماعية التي اتبعها ستالين في 1932-1933، عانت أوكرانيا من المجاعة الجماعية المعروفة باسم هولودومور، والتي تسببت في موت “ما بين 7 إلى 10 ملايين” شخص من الجوع.
خلال الحرب العالمية الثانية، اتخذت قوات الاحتلال النازي ملايين الأوكرانيين عبيداً يعملون بالسخرة، وأبادت اليهود الأوكرانيين والأقليات الأخرى، كما دارت بعض أعنف المعارك بين قوات الاحتلال الألمانية والقوات السوفيتية على الأراضي الأوكرانية.
تتراوح الخسائر الأوكرانية في الحرب العالمية الثانية بين 5 و7 ملايين نسمة. وقد كان انهيار الاتحاد السوفييتي مؤلماً جداً لأوكرانيا؛ ويلخص أحد المؤشرات معاناتها الهائلة: انخفض عدد السكان الأوكرانيين من 52 مليوناً عند انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 إلى 43 مليوناً حالياً.
اليوم، أوكرانيا هي الضحية مرة أخرى.
قد يكون لدى روسيا مخاوف أمنية مشروعة تجاه الناتو، لكن هل هناك قانون على الأرض يحرم أوكرانيا والأوكرانيين من حقهم المشروع في الأمن والكرامة والاستقلال؟
—————————
غزو أوكرانيا بدأ من سوريا/ ديانا مقلد
سوريا اليوم هي محمية روسية، والأسد ليس أكثر من دمية بيد موسكو تارة وطهران تارة أخرى.
لم يبد نظام حماسة لحرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا بقدر حماسة النظام السوري الذي كان أول دولة عربية تعلن صراحة دعمها لغزو أوكرانيا. وهاهي القوات الروسية احتفلت في قاعدتها الشهيرة في مطار حميميم شمال سوريا.
هذه الحماسة تبدو متوقعة، فالأزمة السورية لا تزال مستمرة دون أن يلاحظها أحد خصوصاً من الغرب، وجرائم الحرب من تجويع وقصف وتعذيب واعتقال لم تتوقف، بل هي متصاعدة في ظل الدكتاتورية السورية التي ترعاها روسيا.
بل هناك من يحاول إعادة تعويم بشار الأسد.
على عكس الأسد فإن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكيلم لم يرحب ببوتين، رغم إدراكه أن الصوت العالي في الغرب احتجاجاً على تصعيد بوتين لن يتجاوز حدّ الفقاعات الصوتية التي لن تفضي الى خطوات فعلية.
أليس هذا ما علمتنا اياه التجربة السورية؟
الأمم المتحدة أزالت مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية في عام 2014. ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف نظام الأسد عن قصف المستشفيات والمدارس وممارسة التجويع والتعذيب والتهجير الممنهج.
في العام 2015، أعلنت روسيا عن دخولها العسكري الى سوريا بهدف محاربة تنظيم “داعش”. وتحول ذلك حتى اليوم إلى أكبر وأطول تدخل خارجي للجيش الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
تميز التدخل العسكري ببطشه وباستغلال القصف الجوي وسياسة الأرض المحروقة التي يصفها محللون عسكريون بأنها السياسة التي يعتمدها الآن بوتين في أوكرانيا.
فحملة القصف التي شنتها روسيا ضد خصوم الرئيس السوري بشار الأسد، أحدثت دماراً هائلاً. والغضب الكلامي الذي أعلنته قيادات الغرب من تدمير المستشفيات، لم يخفف من الجنوح الروسي لتوظيف القوة النارية والتدميرية في الحرب على المدنيين.
سوريا اليوم هي محمية روسية، والأسد ليس أكثر من دمية بيد موسكو تارة وطهران تارة أخرى. إدلب مثلا، وهي منطقة خارج سيطرة النظام والروس، قد تمثل نموذجاً يمكن للمرء أن يقيس عليه منسوب العنف الروسي. فملايين السوريين هناك محاصرون، ومستهدفون بالقصف الجوي اليومي والحياة هناك تشبه الجحيم على الأرض. حتى الأمم المتحدة أدارت ظهرها لإدلب، وحولت مساعداتها للأسد وزوجته لتوزيعها وفق حسابتهما.
إذا سقطت أوكرانيا، سيميل ميزان القوى إلى حد كبير نحو الشرق. قبل ذلك فرض اعتماد الكثير من الدول الأوروبية على الغاز الروسي، صمتاً وقبولاً بدور روسيا في سوريا. واليوم تبدو روسيا مندفعة نحو أوكرانيا في ظل أسعار النفط المرتفعة، وهي أكثر استعدادًا لمواجهة الناتو مما كانت عليه قبل بضع سنوات. أكملت روسيا استثمارها في قوتها العسكرية وهي تدرك أن اللحظة هي لحظة انكفاء أميركي غربي.
غزو أوكرانيا بدأ من سوريا، وتحديداً من ذلك الصمت الذي أبداه الغرب حيال موبقة بوتين الأولى.
فهل ستكون الاستجابة لعدوان بوتين مشابهة لما حصل في سوريا؟
درج
————————–
ماذا بعد غزو أوكرانيا؟/ عبد الرحمن الراشد
لن تقوم حرب عالمية ثالثة تقضي سريعاً على معظم ما هو حي على كوكب الأرض. قد يكون الأسوأ منها، حروباً طويلة متعددة الجبهات، بالأسلحة التقليدية، تديرها دول تملك القوة النووية.
حتى من دون حرب عالمية، تظل الأزمة الحالية أبعد مدى من أوكرانيا، وأعمق وأخطر مما تبدو. حلف الناتو متوجس من أنها البداية، لا يدري ماذا يخطط له الرئيس فلاديمير بوتين بعد أوكرانيا. هل ينوي الروس الاستيلاء، أو استعادة، عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابقة، وبنفس المسوّغات التي استُخدمت هذا الأسبوع، باسم التاريخ، والجغرافيا، والتراب، والدين، والديون المالية، وحماية الأمن القومي، والرد على تمدد الناتو، أو استجابةً لاستغاثة من إقليم انفصالي أو جماعة معارضة…؟
النشاط العسكري الروسي في بيلاروسيا وطاجيكستان يعزز فكرة أننا في بداية مشروع روسيا البوتينية. وبوتين هو من روسيا الإمبريالية القيصرية، وضد البلاشفة الروس، وإن كان يتحدث عن الاتحاد السوفياتي كمرجعه التاريخي في استعادة ما هو «حق» لروسيا.
بضم أوكرانيا أو معظمها، نكون قد شهدنا دورة متكاملة لحدث عالمي 360 درجة، حيث عادت الحرب الباردة، على الأقل في حياة مَن هم مثلي.
ما الخطوة الروسية المحتملة التالية؟ هل تكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الوجبة الثانية؟ هناك 15 دولة انفصلت عن الاتحاد السوفياتي يعدّها القوميون الروس لهم، ويعدّون الغرب مذنباً فيما حدث. الرئيس بوتين هو المنظّر لهذا الطرح، ورسم في خطابه الماضي خريطة سياسية مهمة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي. قال: «قيادة الحزب الشيوعي ارتكبت الكثير من الأخطاء التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، وإن حق الجمهوريات في مغادرة الاتحاد كان بمثابة (القنبلة الموقوتة) تحت الدولة الروسية التي كانت تسمى الاتحاد السوفياتي آنذاك».
الأعمق والأبعد أن روسيا البوتينية تبدو عازمة على التمدد، وحلف الناتو ودول الغرب يواجهان وضعاً صعباً، حيث إن الدخول في مواجهة مباشرة مع دولة نووية أمر خارج الاحتمالات. دخول أوكرانيا هو بيان سياسي يؤذن بعالم مختلف لا يمكن أن نعرف أبعاده حتى في مناطق النزاعات الأخرى في العالم.
الحل السياسي بعيد الاحتمال، أن تدفع أزمة أوكرانيا القوى الكبرى إلى البحث عن صيغة تعايش جديدة مبنية على عدم استخدام القوة لحسم الخلافات، آخذة في الاعتبار تقديم الضمانات الأمنية، وهي المبرر الذي تكرر موسكو الحديث عنه في اعتراضها على حلف الناتو. ولا شك أن العالم، منذ نهاية الحرب الباردة افتقد نظام القطبين، الذي كان رغم سيئاته يضمن استقراراً على الجبهات الكبرى.
لم يأتِ الغزو مفاجأة، بل كان من الاحتمالات المتوقعة، واستخدام الغاز ضد أوروبا أيضاً كان أمراً متوقعاً، مع هذا لا يوجد حل عسكري على مستوى الدول الكبرى، والخشية أن يكون الخيار العسكري عند الغرب هو فتح جبهات أخرى من خلال دول أخرى لمنع موسكو من الاعتقاد أن أوكرانيا يمكن تكرارها مرة أخرى.
أما العقوبات الاقتصادية فإنها، كما نعلم جيداً، سلاح فاشل، خصوصاً مع أنظمة مستعدة لتحمل الثمن مهما كان قاسياً. المفارقة هي أن الذي يدفع ثمن عقوبات غزو أوكرانيا هو الغرب ودول العالم، مع التضخم وارتفاع الأسعار لسلع حيوية مثل الطاقة والقمح.
الشرق الأوسط
———————–
أوكرانيا… صراع مفتوح وعصر جديد من العلاقات الدولية
خالد حمادة
بإعلانه العملية العسكرية ضد أوكرانيا، نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواجهة مع الغرب من منطقة التماس إلى العمق الأوكراني. لكن هذا لم يكن ممكناً لولا تراكمات الأزمة الأوكرانية التي أتاحت لروسيا فرصة نادرة لإيجاد موطئ قدم.
فبدءاً من الاحتجاجات الجماهيرية وتغيير النظام في 2014، وبعدها الحرب المفتوحة في «دونباس»، وضعت الهوية الأوكرانية أمام اختبار شديد التقطت مفاتيحه روسيا. وأدّى عجز مجموعة النورماندي، المشكّلة من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، عن وقف القتال بموجب اتفاقيات مينسك الأولى والثانية لعامي 2014 و2015، إلى تقسيم منطقة الدونباس التاريخية إلى قسمين يفصلهما خط مواجهة.
أتاح ذلك المجال لدمج تدريجي للإقليمين المنفصلين في الهياكل السياسية والاقتصادية والأمنية لروسيا، من خلال توزيع جوازات السفر الروسية، وإدخال الروبل كعملة محلية وإعادة توطين الشركات والتنسيق الأمني، بالتوازي مع رفع الحكومة الأوكرانية يدها عن الإقليمين بهدف زيادة تكاليف الحرب على موسكو.
وسهّلت المسافة المادية والسياسية المتزايدة على مدى السنوات الماضية بين جزأي دونباس (الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جهة والإقليمان المنفصلان من جهة أخرى)، مسألة فرز الهويات وتشتيت مواقف السكان المحليين، بين فريق متمسك بانتمائه الأوكراني، وآخر يرى نفسه في الفلك الروسي.
غير أن اللافت هو أن الحيّز الجغرافي للجمهوريتين الجديدتين، وفق إعلان بوتين الاعتراف بهما، يغطي الحدود الإدارية للإقليمين بما يتجاوز المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، وبما يعيد التذكير بالشروط التي نصّ عليها مؤتمر مينسك، مما يعني أنّ المجال أضحى متاحاً أمام موسكو لمزيد من التوّغل في العمق الأوكراني وتنفيذ احتلال جزئي لمناطقها الشرقية، من مدينة خاركوف شمالاً حتى دنبّر وماريوبل جنوباً، ليتمّ الاتصال مع شبه جزيرة القرم والسيطرة على بحر آزوف وتحويله إلى بحر داخلي روسي يمكن إغلاقه أمام حركة الملاحة الغربية.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ شروط التسوية السياسية اكتسبت بُعداً جديداً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الأمن الدولي وبمستقبل القارة الأوروبية بشكل خاص.
فهل كانت الأزمة الأوكرانية خارج توقّعات الولايات المتّحدة والدول الغربية، أم أنّ هذه الدول أساءت تقدير ردّة الفعل الروسية، التي تبدو اليوم خارج السيطرة ومستعصيّة على الدبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها؟
في بداية هذه الأزمة، كان يكفي تعهد أميركي واضح بعدم وجود أي طموح لإدخال أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبعدم الرغبة في نشر المزيد من المنظومات الصاروخية، لإحراج بوتين وتعديل مسار الأزمة. لكن الإمعان الأميركي في وضع السيناريوهات العسكرية ونقل أجواء الحرب إلى أوروبا يُظهر إرادة واضحة في دفع روسيا للتّورط بالحرب مع أوكرانيا.
لهذا السبب، تمّ إفشال اجتماع النورماندي الأخير لتنفيذ مقررات مينسك المتعلّقة بمنح الاستقلال الذاتي للإقليمين. ولهذا السبب أيضاً، لم تقم واشنطن والدول الأوروبية بأي مسعى لدى كييف لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في الدونباس.
لقد تناقلت الصحف عن مسؤولين أميركيين أنّ الولايات المتّحدة أبلغت حلفاءها بأنّ العاصمة كييف ومدن خاركيف شمالاً ولاوديسا وخيرسون جنوباً، يمكن أن تكون هدفاً لغزو محتمل استناداً لقدرات القوى العسكرية المحتشدة على الحدود. وسبق ذلك إخلاء سفارة الولايات المتّحدة في كييف ونقل العمليات إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولونيا. كما أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة في جنيف بثشبا كروكر، مجلس حقوق الإنسان، بأنّ لدى واشنطن معلومات حول إعداد موسكو قائمة بالأوكرانيين «الذين سيتم قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات بعد الاحتلال العسكري».
– 3 أهداف للمناورة الأميركية
محاولة فهم هذه المناورة الأميركية تقود إلى أهداف كثيرة تبدو منطقية، منها:
أولاً، إخضاع السيطرة الأميركية على دول حلف «الناتو» لاختبار جديد بالتلويح بوجود خطر فعلي يهدد الأمن الأوروبي، ولا شيء أفضل من دفع روسيا إلى التورط في حرب مع أوكرانيا التي تجمع ميزات عدة تتصل بالأمن الأوروبي على مستوى الطاقة والاقتصاد.
ثانياً، وضع حدّ للصعود المطرد للعلاقات الروسية – الأوروبية، خصوصاً الاقتصادية مع ألمانيا، التي باتت ترفض الانصياع للإملاءات الأميركية، لا سيما فيما يتعلّق بالموقف من «نورد ستريم – 2». هذا الخط الذي تعده ألمانيا عاملاً أساسياً في استقرارها الاقتصادي بعد أن اتّخذت قرارها بالاستغناء عن الطاقة النووية ووقف استخدام الفحم الحجري.
ثالثاً، فرض عقوبات اقتصادية قاسية، تشارك بها أوروبا، على صادرات الغاز من روسيا لإرهاق اقتصادها وإفساح المجال لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية بعيداً عن موسكو.
– ثمن بوتين للتراجع
على أن السؤال الأكثر تكراراً الآن هو: ماذا بعد استقلال الجمهوريتين وإعلان «الناتو» أنه ليس في وارد إرسال وحدات عسكرية للدفاع عن دولة ليست عضواً في الحلف، والاكتفاء بإرسال تعزيزات عسكرية؟ وماذا بعد فشل الدبلوماسية في اختراق الوضع القائم وتحول عمليات إطلاق النار المحدودة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في شرق البلاد إلى حرب استنزاف لن تستطيع كييف تحمل تكلفتها على المستويات كافة؟
بعبارات أخرى، تحوّلت أوكرانيا إلى حقل معركة لصراع دولي يشتبك فيه الاقتصادي بالأمني، وتقف عند تخومه كلّ من الولايات المتّحدة وروسيا، وتدفع أوروبا ثمناً باهظاً لاستمراره. والسؤال الآن لم يعد ما إذا كان سيتمّ المضي قدماً، ولكن إلى أي مدى؟ وهل يمكن أن يعني الانتقال إلى الدبلوماسية أقل من المطالبة بتغيير النظام وتنصيب فريق موالٍ للكرملين ووقف أي محاولة للانضمام للناتو والاعتراف بالجمهوريتين وتطبيق اتفاقات مينسك 2014؟
لقد رفع الكرملين مستوى المخاطر بشكل كبير، لدرجة لم يعدْ معها التراجع محتملاً ما لم يتمكّن من كسب شيء في المقابل، أقلّه الدفع باتّجاه المزيد من التنازلات الاستراتيجية فيما يتعلّق بالأمن الأوروبي ودور «الناتو».
– ما أهمية أوكرانيا للغاز الأوروبي؟
لقد اعتادت أوكرانيا أن تكون محطة رئيسية في نظام الطاقة الأوروبي، لكن الحال اليوم لم يعدْ كما كان عليه في العقد الأخير من القرن الماضي، حين كان معظم الغاز الروسي إلى أوروبا يمرّ عبر أراضيها. لقد قامت روسيا منذ ذلك الحين بتنويع الطرق بواسطة خط أنابيب «يامال» عبر بيلاروسيا وبولندا، وخطي أنابيب «بلو ستريم» و«ترك ستريم» إلى تركيا، وخط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى ألمانيا و«نورد ستريم 2» الذي ينتظر التصديق، مما أدى إلى خفض نقل الغاز عبر أوكرانيا بنسبة 70% بين عامي 1998 و2021 إلى أقل من 42 مليار متر مكعب. لقد خفّضت خطوط الأنابيب الجديدة عدد الدول التي تعتمد على الإمدادات عبر أوكرانيا. اليوم، أوكرانيا هي ممر عبور للغاز المتّجه إلى سلوفاكيا، وما بعده إلى النمسا وإيطاليا.
وخلصت المنظّمة الأوروبية لمشغلي خطوط نقل الغاز، في تحليل حديث لها، إلى أنّه يمكن التعايش مع التأثيرات النهائية لانقطاع الإمدادات الأوكرانية، بافتراض وجود سوق تعمل بشكل جيد وتعاون إقليمي.
وبالمثل، يلفت نيكوس تسافوس من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أن «انقطاع تدفّق الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر على سلوفاكيا والنمسا وإيطاليا، ولكلٍّ منها خيارات مختلفة للتعامل مع ذلك… إيطاليا لديها بدائل كثيرة كونها دولة بحرية، كما أنّ بولندا لديها خيارات بديلة أكثر من أي وقت مضى. وستكون مولدوفا في موقف أكثر صعوبة على الرغم من وصول وارداتها عبر طريق مختلف. وستتوقف قدرة هذه البلدان للوصول إلى البدائل على ظروف السوق العالمية وكمية الغاز المخزنة في أنحاء القارة الأوروبية». لكنه لفت إلى أن القتال المحلي قد لا يؤثّر على تدفقات الغاز، في حين أنّ الحرب الشاملة قد تستهدف البنيّة التحتيّة للغاز عن طريق الصدفة أو بقصد الحصول على مكاسب عسكرية.
لا يزال قطع طرق إمداد النفط والغاز عن أوروبا سلاحاً يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية، بدليل أنّ روسيا لم تلعب دوراً مطمئناً لمعالجة الذعر الذي اجتاح السوق. صحيح أنّ الاعتماد على مبيعات النفط والغاز لأوروبا أقل مما كان عليه خلال الحرب الباردة، إذ توجد الآن سوق عالمية للنفط وسوق غاز بديلة في شمال شرقي آسيا، ولكنّ حجب روسيا المزيد من الإمدادات ستكون له كلفة باهظة على اقتصادها. غير أن المسألة الأهم لموسكو هي المقايضة الدقيقة بين الحافز الاقتصادي للحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة والحافز الأمني للتأكّد من عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» مطلقاً، وهي ترى نفسها في وضع ملائم تماماً لأنّ أوروبا تتّخذ خطوات واسعة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، ولكنها في الوقت نفسه لا تجد بديلاً عن الغاز الروسي.
– عقوبات وقيود وإلزامات
تعتمد أوروبا على روسيا لتأمين نحو 40% من غازها و25% من وارداتها النفطية. وبالتالي فإنّ أي اضطراب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية. طبعاً يمكن للاتحاد الأوروبي التعامل مع وقف قصير الأجلّ لواردات الغاز الروسي، على الرغم مما يترتب على ذلك من «عواقب اقتصادية عميقة» وتدابير طارئة لتقييد الطلب الصناعي وصعوبة الحصول على واردات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. لكن إدارة الاقتصاد الأوروبي لعدة سنوات من دون الغاز الروسي تمثّل تحديّاً مختلفاً.
لقد زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتّحدة وقطر ودول أخرى في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020 انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بنسبة 9%. ومع ذلك، ظلّت روسيا المورِّد الأكبر للاتحاد الأوروبي، إذ استحوذت على 43% من الغاز المستورد، تليها النرويج والجزائر.
بالإضافة إلى ذلك، عززت أوروبا مناعتها منذ أزمتي الطاقة في عامي 2006 و2009 واستثمرت المليارات في توسيع البنيّة التحتيّة التي تسمح لها باستيراد الغاز عن طريق السفن ونقل الوقود بسهولة أكبر عبر القارة، والاستفادة من واردات خطوط الأنابيب من النرويج وشمال أفريقيا وأذربيجان. بالإضافة إلى أحجام إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لتحلّ محل الإمدادات من روسيا. لكن الحصول على جزيئات بالمقاس المطلوب لاستبدال الأحجام الروسية بالكامل أمر مكلف للغاية في أفضل الأحوال، وربما غير ممكن.
أما القيود على مسألة تعويض أوروبا نقص الغاز الروسي فكثيرة، ومنها أنّ هناك حدوداً لمقدار إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقله، كما أنّ قدرة التسييل العالمية تُستخدم بالكامل تقريباً وكذلك سفن الغاز الطبيعي المسال. يقول رئيس وزراء النرويج، ثاني أكبر مورِّد لأوروبا، إنّ بلاده تقدّم الغاز الطبيعي بأقصى طاقتها ولا يمكنها تعويض أي إمدادات تحجبها روسيا. كما أنّه يمكن لقطر (أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم) إرسال بعض الغاز الإضافي إلى أوروبا، لكنّ الإمدادات الاحتياطية ستكون شحيحة بسبب الارتباط بعقود سابقة. كذلك، فإنّ اليابان مستعدة لتحويل بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ولكن السفن ستأتي من موانئ في الولايات المتّحدة، وليس من اليابان مباشرةً.
صحيح أنه يمكن للغرب أن يفرض مجموعة متنوعة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك جعل شراء الدول والشركات للنفط والغاز من عملاقتي الطاقة «روسنفت» و«غازبروم» غير قانوني. كما أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة بصدد معاقبة الغاز الروسي رداً على الغزو، مع القدرة على تجنب «ألم قصير الأجل» في أسواق الطاقة الغربية.
لكنّ ذلك كله لا يُلغي أن أي قيود ستُفرض على الغاز الروسي سترفع الأسعار في جميع أنحاء أوروبا، لذلك تبقى مسألة وقف شحنات الغاز من روسيا مجرد فكرة نظرية رغم قدرتها على التأثير على ما قد يصل إلى 50% من مداخيلها بالعملة الصعبة.
إنّ أبرز إجراء قد يُقْدم عليه الغرب هو إحباط خط «نورد ستريم 2» الذي يمتد تحت بحر البلطيق بطول 1225 كيلومتراً لمضاعفة صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا، والذي استغرق بناؤه خمس سنوات بكلفة 11 مليار دولار، وعُلّقت الموافقة عليه لأنّه لا يمتثل للقانون الألماني.
مع ذلك، وعلى الرغم من الخطاب عالي النبرة في واشنطن التي هددت بوقف الخط، لا يمكن لألمانيا ببساطة إلغاء «نورد ستريم 2» لأنه منجز بالفعل، كما أن لديها أكثر من حافز لتشغيله بعد قرارها التخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم بالتوازي، مما يجعلها أكثر اعتماداً على الغاز، وهذا ما سيجعل الروس يفكرون مليّاً في هامش الحركة المتاح أمامهم.
– فرص ومخاطر لدول المنطقة
يوفر الصراع الروسي – الأوكراني المفتوح فرصاً لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما النفطية منها لتعزيز مواقعها في مجال العلاقات الدولية. فمن المنطقي أن تسعى المملكة العربية السعودية إلى وضع الطلبات الأميركية والأوروبية لزيادة إمدادات النفط لصالح تعزيز موقعها. وكذلك ستطمح قطر في المقابل للحصول على تنازلات أوروبية، قد يكون على رأس قائمتها تأجيل المفوضية الأوروبية تحقيقاً مدته أربع سنوات في استخدام الدوحة المزعوم لعقود طويلة الأجل لمنع تدفق الغاز إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وقد تتخذ دول شرق أوسطية أخرى مواقف أكثر تحفظاً في رهاناتها. فقد شهد العقد الماضي ازدهاراً في العلاقات الأمنية والاقتصادية بين روسيا والكثير من الدول في الشرق الأوسط، مدفوعاً بإحساس بتناقص الاهتمام الأميركي بالمنطقة.
تركيا بدورها ستكون أيضاً جزءاً مهماً من المعادلة، كونها عضواً في «الناتو» ولها علاقات وثيقة بكلّ من روسيا وأوكرانيا. وسيعزز الصراع في أوكرانيا تنافس روسيا والغرب على جذب أنقرة، إذ تحرص واشنطن على أن تواصل أنقرة مبيعاتها من الأسلحة إلى كييف. طبعاً من غير المرجح أن تتحالف تركيا بشكل كامل مع الغرب ضد روسيا تجنباً لمزيد من التعقيدات، لكنّ هذه الديناميكيات ستؤدي بلا شك إلى سياسة خارجية تركية أكثر ثقة بالنفس، تحديداً في البحر الأبيض المتوسط وسوريا، وتخفيف حدّة الانتقادات الغربية للوضع التركي الداخلي.
في المقابل، على أوروبا أن تدرك أنّ العقوبات المرتقبة قد تدفع بموسكو إلى استخدام موقعها في ليبيا للرد، من خلال استغلال الصراع المتجدّد هناك وزيادة تدفقات الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط. كما أنّ تصاعد الصراع في أوكرانيا قد يعيق إحراز تقدم ولو متواضع في القضايا الإنسانية، في المفاوضات بشأن سوريا بين روسيا والولايات المتّحدة.
أحد الانعكاسات المهمة قد يكون في التأثير على مسار المفاوضات في فيينا التي لعبت روسيا دوراً بنّاءً في جولاتها الأخيرة، إذ عملت عن كثب مع الجهات الغربية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
أما إسرائيل، فمن المحتمل أن تتخذ موقفاً براغماتياً من الصراع الأوكراني، رغم تحالفها العميق مع الولايات المتّحدة. فمنذ أن نشرت موسكو جيشها في سوريا، أصبح المسؤولون الإسرائيليون ينظرون إلى روسيا على أنها جارهم الجديد في الشمال الذي يعتمدون على تعاونه في شن ضربات جوية ضد أهداف إيرانية في العمق السوري.
– أوكرانيا ووطأة الجغرافيا
تدفع أوكرانيا اليوم أثمان موقعها الجغرافي، على تخوم إمبراطورية صاعدة تحاول استعادة إرثها وتنشد تسليماً دولياً بدورها كقوة عظمى، وتحالف دولي قادته الولايات المتّحدة ليتمدد على أنقاض العملاق السوفياتي الذي أعلنت نهاية التاريخ بعد سقوطه.
استفاد الرئيس الروسي من دروس الجغرافيا السياسية التي لم تعنِ شيئاً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين الذي كان يرفض تدريسها في الكليات العسكرية السوفياتية. واستغل بوتين بنجاح كلّ نقاط الضعف المتاحة، من مسألة القوميات حتى تعقيدات إمدادات الطاقة التي تعد عصب الحياة والاقتصاد، مروراً بالجغرافيا.
ومع إعلان العملية العسكرية والاعتراف باستقلال الجمهوريتين في الدونباس، تدخل أوكرانيا مرحلة الرضوخ القسري لواقع جديد مفتوح على مزيد من التداعيات السياسية والأمنية، قد تكون أولى نتائجه القبول بدولة اتحادية وربما التعايش مع مشروع روسيا الموسعة في المستقبل.
————————-
أميركا ترسم ملامح التوسع الروسي.. الأفخاخ تطوق أوروبا/ منير الربيع
يؤسس الصراع الروسي الغربي على أوكرانيا لمرحلة جديدة من التوازنات السياسية والجغرافية في أوروبا والعالم. وهي توازنات سيكون لها أثر تفاعلي مع جملة عوامل، أولها طاقوية (من طاقة) بسبب الصراع على ممرات النفط والغاز. وثانيها قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية. وثالثها الدخول إلى مرحلة من إعادة رسم الكيانات السياسية. الأداء الروسي والأميركي في معركة أوكرانيا غريب جداً، فموسكو تؤكد باستمرار عدم استعدادها لتنفيذ الاجتياح العسكري إنما هي تريد تحقيق مكاسب سياسية والحصول على ضمانات رسمية ومكتوبة تتعلق بعدم دخول روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووقف توسع حلف الناتو في محيط روسيا أو الدخول إلى الدول التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفييتي. ما يريده الروس هنا هو الالتزام الأميركي بالاتفاق المسبق الذي كان قد عقد بين رونالد ريغن وغورباتشوف، وفيما بعد بين جورج بوش الأب وبوريس يلتسن حول تعهد واشنطن بعدم تمدد حلف الناتو إلى الدول السوفييتية السابقة، علماً أن الحلف خرق هذا الاتفاق طوال السنوات الفائتة.
ما يدّعيه فلاديمير بوتين أن هذا التوسع لحلف الناتو في أوروبا الشرقية هو محاولة لتطويق روسيا، فيما هو يسعى في كل مرّة إلى توسيع حضوره وتعزيزه مستفيداً من أي حركة أميركية تبدو وكأنها معارضة لطموحات وتطلعات الكرملين. في المقابل، هناك صورة عسكرية أميركية لا بد من قراءتها منذ دعم واشنطن للثورة الأوكرانية في العام 2014، فعلى إثرها نجح بوتين في تحقيق خروقات داخل أوكرانيا واجتاح القرم وضمّها إليه. وهو مسار ثابت لدى الروس الذين يسعون للمراكمة على أي تحرك أميركي في سبيل الانقضاض أكثر، فما حصل في جورجيا قبل أوكرانيا خير مثال على ذلك، والأمر نفسه تكرر مثلاً في كازاخستان مؤخراً والتي استغل فيها بوتين تحركات ومسعى للانقلاب فتدخل منقضاً عليها ومحكماً سيطرته مجدداً.
في موازاة المواقف الروسية التي لا تتبنى مبدأ الاجتياح لا بد من تذكر الآلية السياسية والدعائية الروسية في مرحلة ما قبل الدخول إلى سوريا، فحينها لم يُطلق أي موقف روسي يتعلق بالتدخل، حتى وُضع الجميع تحت الأمر الواقع، وبعدها لطالما صدرت مواقف علنية عن المؤسسات الروسية تؤكد أن القوات العسكرية تجري انسحاباً من سوريا، فتكون النتيجة عكسية بتعزيز الحضور وتوسيعه والسيطرة على مساحات أوسع. هذه الطريقة الروسية في مقاربة الملفات الاستراتيجية، هي نفسها التي يعتمدها الأميركيون، فيرفعون سقوف التحدي ضد موسكو تحت عنوان تطويقها وتقويض نفوذها، فيما تأتي كل النتائج لصالح التوسع الروسي. والغريب أكثر في الأمر، أن الأميركيين يحاولون إحراج الجميع من خلال التصريحات المكثفة يومياً حول تحديد مواعيد الاجتياح الروسي لأوكرانيا لدرجة تشير إلى أن واشنطن تتمنى حصول الاجتياح، وما هو أغرب هو تعاطي الرئيس الأوكراني مع هذه المواقف الأميركية بعين الريبة والتحسب لما ينصبه الأميركيون من أفخاخ.
وهي أفخاخ خبرها العرب قبل غيرهم منذ اجتياح العراق وصولاً إلى التعاطي الأميركي مع الثورة السورية، فكل هذه السياسات والحروب كانت تحت عنوان محاربة إيران والإرهاب، إلى أن استفاقت منطقة الشرق الأوسط والدول العربية على توسع إيراني بعيد المدى طال العراق، سوريا، لبنان واليمن، من خلال خلق ذريعة محاربة الإرهاب على مرأى من الأميركيين. الأمر نفسه يتكرر في أوروبا في ظل وجود رئيس روسي طامح لاستعادة الأمجاد القيصرية ولا لجام لجموحه في التوسع أكثر. ما شهدته المنطقة الشرقية من أوكرانيا في الأيام الماضية من تطورات عسكرية وتفجيرات، تشير إلى أن المشروع قد يتركز على تقسيم أوكرانيا إلى جهتين، شرقية موالية للروس وغربية موالية للغرب، في استعادة لتجربة ألمانيا وهذا ما تجلى في اعتراف بوتين في استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ولكن أي مشروع من هذا النوع سيكون انعكاسه الأكبر على أوروبا ككل، كنوع من تهديد قادر على خلخلة قواعد الاتفاق، في ظل الصراع على خطوط الغاز. هنا لا بد من العودة إلى نظرية تصغير الكيانات، والتي خبرها العراق وسوريا من قبل، فيما هناك تلويح بإعادة تكريسها في لبنان بضوء مشروع يتم تقديمه على الكونغرس الأميركي يتعلق بتقسيم لبنان إلى منطقتين، منطقة يتم فيها تنفيذ مندرجات القرار 1559 وتكون خاضعة لسيطرة غربية، مقابل احتفاظ حزب الله بمناطق سيطرته.
تلفزيون سوريا
—————————-

هل ستصبح روسيا قوة عالمية على حساب سورية وأوكرانيا؟/ علاء الدين الخطيب
مدخل
قال فاليري غيراسيموف[1]، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، أمام اجتماع عام لأكاديمية العلوم العسكرية عام 2019 عن التدخل العسكري الروسي في سورية: “لقد طوّرت روسيا استراتيجية الضربات المحدودة خارج الحدود الوطنية”. وأضاف: “أساس تنفيذ هذه الاستراتيجية هو إنشاء مجموعة من القوات ذات الاكتفاء الذاتي على أساس تشكيلات أحد أفرع القوات المسلحة، التي تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقادرة على تقديم أكبر مساهمة في حل المهام المعينة”، “في سورية، يتم تعيين مثل هذا الدور لتشكيلات القوات الجوية”.
وأوضح أن “أهم شروط تنفيذ هذه الاستراتيجية هو اكتساب التفوق المعلوماتي والحفاظ عليه، والاستعداد الاستباقي لأنظمة القيادة والسيطرة والدعم الشامل، وكذلك النشر المموَّه للتجمع الضروري”.
لقد كان الاقتحام العسكري الروسي لسورية أوّل امتحان للدروس المتراكمة التي كانت القيادة العسكرية الروسية تتعلمها، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وقد بدأت تلك الدروس مع عملية “عاصفة الصحراء” لتحرير الكويت من الغزو الصدامي 1991، والتي شكلت آخر ضربة مهينة للاتحاد السوفييتي، وورثت روسيا الاتحادية صدمات ودروس عسكرية كبيرة في تلك العملية. ثم كان الاختبار الأمرّ والأصعب لروسيا الناشئة على حطام السوفييت، في حرب طويلة مرهقة ومليئة بالفشل في الشيشان ما بين 1994 و2009، ومع أن نهايتها كانت انتصارًا لروسيا، فإن مقارنة ما كان يفترض أنه ثاني أقوى الجيوش في العالم مع مجموعات ميليشياوية غير مدرّبة ولا مجهّزة عسكريًا، إضافة إلى طول مدة الحرب والتكاليف، يضع هذا الانتصار أمام أسئلة كبرى.
وتكرر الانتصار الصعب نفسه، الذي يواجه سؤال معنى الانتصار، في الحرب الروسية في جورجيا عام 2008، فالمواجهة كانت أيضًا مع عدو أضعف وأصغر بكثير من القوة الروسية، لكن الانتصار كان صعبًا ومرهقًا.
روسيا والقيصر بوتين
أمضى فلاديمير بوتين، الذي قال عن انهيار الاتحاد السوفييتي بأنه أكبر مأساة شهدها القرن العشرين [2]، سنواته الأولى في الحكم في تثبيت سلطته كحاكم أوحد قيصرًا لروسيا، لاستعادة ما كان يراه بوتين وكثير من الروس مكانة السوفييت المفقودة. وفي الوقت نفسه كان يحاول جس نبض الغرب حول سؤال: كيف ستقبلون روسيا الجديدة، قوة عظمى ندًا لوجودكم في أوروبا والعالم، أم ساحة استثمار وربما انتقام لسبعين سنة من الخوف من الاتحاد السوفييتي؟ وكانت النتيجة هي أن الغرب لن يرى روسيا إلا وفق الخيار الثاني، بشكل أو بآخر، سواء رؤية الاتحاد الأوروبي الجار الجغرافي والقوة الاقتصادية الكبيرة، أو عبر رؤية الولايات المتحدة الأميركية كقطب عالمي أوحد.
لم يقتصر تركيز بوتين على ترسيخ سلطته وقوته داخل روسيا الاتحادية، بل امتدّ أيضًا إلى ضمان ما يراه أمن روسيا القومي في دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول حلف وارسو؛ فكان توسع حلف الناتو في أوروبا باتجاه الشرق من أسوأ الكوابيس التي لازمت القيادة الروسية مع سياسة المحافظين الجدد الأميركيين 2000-2008، الذين خاضوا حربَي أفغانستان 2001 والعراق 2003، ليرسخوا وحدانية قطبيتهم العالمية. ثم جاءت إدارة باراك أوباما عام 2008 بعد المواجهة الحاسمة في جورجيا مع خطط الناتو، وبالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، لتعلن توجهها الاستراتيجي للتركيز على احتواء الصين، من خلال الحركة السياسية والعسكرية في المحيط الهادي، وعبر وسط آسيا أو ما يُعرف بالدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي (الشكل 1)، التي تشمل أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان، ويمكن تمديدها ضمن الاهتمام والتداخل الجيوسياسي إلى أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، والتي تُعرف باسم استراتيجية المحور الباسيفيكي[3] (نسبة للمحيط الهادي أو الباسيفيكي)، والتي كانت تعني بالضرورة احتواء روسيا الاتحادية أيضًا. فدول وسط آسيا تشكل الخاصرة الضعيفة بالنسبة للصين، وبالنسبة لروسيا أيضًا، فهذه الدول كلها تعيش تحت حكومات دكتاتورية فاسدة، ومُتخمة بالأزمات الكامنة داخل كل دولة، وفيما بينها؛ فضلًا عن أنها متداخلة سكانيًا مع غرب الصين وجنوب روسيا الاتحادية، تداخل عرقي وديني حيث يشكل المسلمون الأغلبية الساحقة.
الشكل 1 خريطة تبيّن المحيط الجغرافي لروسيا الاتحادية
مع اندلاع ثورات الربيع العربي 2011، وجد العالم نفسه أمام نتائج حتمية لفوضى عالمية هدّامة ظهرت منذ نهاية التسعينيات، مع توسع سيطرة نظام العالم المفتوح أمام التجارة ورؤوس الأموال وتراجع سيطرة الحكومات، وبالتوازي مع انفجار ثورة الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.
لم يكن الموقف الروسي أقلّ اهتمامًا وقلقًا من تداعيات هذا الحراك الجماهيري، حيث كان مع الصين أكثر قلقًا وتخوفًا من سرعة حركة ثورات الشعوب؛ خاصة أن المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي، مرورًا بشرق البحر المتوسط وإيران وصولًا إلى حدود الصين الغربية وروسيا الجنوبية، هي المنطقة المُرشحة -ذاتيًا وموضوعيًا- للاهتزاز تحت وقع حركة شعوب مقموعة طلبًا لحياة أفضل (الشكل 1).
وفي سورية التي تشكل نقطة ارتكاز أساسية لتحالف الضرورة بين الصين وإيران وروسيا[1]، والقائم على ضمان السيطرة على وسط آسيا، كان الموقف الروسي أبعد بكثير مما شاع حول الطمع الروسي بثروات النفط والغاز السورية[2]، أو باستثمار الموانئ السورية لصالح العسكرية الروسية، أو تجريب السلاح الروسي الجديد. وهذا لا يعني أن كل تلك العوامل لم تشكل عاملًا إضافيًا في زيادة حماسة الكرملين للتدخل في سورية، لكنها تبقى أقل أهمية من تشكيل دافع لتحركات جيوسياسية ضخمة واستراتيجية الامتداد والآثار؛ فالدافع الأساسي يبقى هو نظرة أمن قومي استراتيجي خارجي[3] تشمل وسط آسيا وصولًا إلى شرق المتوسط، بعد استبعاد الوزن الروسي والصيني في حرب العراق 2003، كانت سورية حجر القبان في حلف الضرورة الثلاثي. فالنظام الأسدي الحاكم لسورية حليف تاريخي للنظام الإيراني، وموقع سورية الجيوسياسي يمثل رابطًا لا غنى عنه للنظام الإيراني مع البحر المتوسط ولبنان وفلسطين، ومع خطورة انتقال موجة الثورات الشعبية إلى إيران[4]، أدى ذلك إلى موقف حاسم من قبل روسيا والصين في دعم النظام الأسدي في سورية، ودعم الدور الإيراني في تجبير كسور بنية النظام السوري؛ فكان أن استخدمت الصين حق النقض الفيتو [5]، مزدوجًا مع روسيا، لصالح النظام السوري 7 مرات، ما بين 2011 و2020، مقارنة باستخدامها للفيتو 8 مرات فقط من 1948 إلى 2010.
كان الاقتحام العسكري الروسي لسورية عام 2015 تحركًا استراتيجيًا مهمًا، فيما يمكن أن نسميه انتقال روسيا إلى سياسة الردع المسبق، مقابل سياسة ردة الفعل التي انتهجتها في الشيشان وجورجيا. وفي الوقت نفسه كان التدخل العسكري الروسي في سورية استثمارًا لخلاصة الخبرات العسكرية المتراكمة لدى الجيش الروسي، وأيضًا اختبارًا لهذه الإمكانيات الجديدة التي ركز عليها بوتين في عملية إعادة بناء الدولة الروسية، التي شملت تحسين الأداء العسكري التقليدي، إضافة إلى دعم توسيع إمكانيات الجيش الروسي في مجال التقنيات المتقدمة وحرب المعلومات وحرب الإعلام واستثمار إمكانيات الصناعة الجوية والفضائية الروسية.
وعلى الرغم من أن التدخّل الروسي في سورية لم يحقق أهدافه المعلنة كاملة، فإنه استطاع إعادة ترميم بنية نظام الأسد، وتوسيع مساحة سيطرته الجغرافية، وبذلك اكتسبَت الإدارة الروسية السياسية والعسكرية خبرات ضخمة بالتعامل المباشر مع عدة أطراف قوية مثل الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإسرائيل وكذلك مع الحليف الإيراني. هذه الخبرات تم وضعها على طاولة الكرملين للنظر في مصالح روسيا على الحدود الغربية أيضًا، وهي الجبهة الأشد خطورة، من خلال مقارنة كل الاحتمالات الواردة.
طبعًا، لا يتوقف الخط الواصل بين سورية وأوكرانيا على بلورة الخبرات السياسية والعسكرية في سورية، لاستثمارها في الأزمة الأوكرانية الروسية، فالبلدان ليسا هدفًا للصراع بحد ذاته، بل هما ساحة صراع القوى الكبرى الإقليمية والدولية، كما خلصت لذلك الباحثة آنا بورشفسكايا[6] في كتابها “حرب بوتين في سورية. السياسة الخارجية الروسية وثمن الغياب الأميركي”.
الدروس التي استفادتها روسيا من سورية على المستوى السياسي
اعتمدت الدبلوماسية الروسية في عملها في سورية على مبدأ شرذمة الأزمة السورية، فبدل أن يكون السؤال أو المشكلة قائمان من مطالب معارضين لنظام الأسد والأسد نفسه، أي من البعد الثنائي للأزمة “أسد-معارضة”؛ إلى تشجيع وخلق الاستقطابات بين ما يمكن تسميته “الحراك السياسي السوري”. وبهذا الواقع، تلاقت مع سياسات الحكومات الكثيرة الإقليمية والدولية التي تداخلت في الأزمة السورية، وعدد كبير منها ممن أعلن تأييده لمطالب الثورة السورية عمومًا، وحرص على توجيه خط سياسي سوري معارض متناسب معه، على حساب باقي المعارضة السورية.
من ناحية ثانية، لم تجد روسيا في تدخّل الأمم المتحدة، عبر دبلوماسية الأطراف المتعددة التي بدأت بمباحثات جنيف والمشاورات مع كل حكومات الإقليم وحكومات الدول الكبرى في العالم، ارتياحًا يناسب دبلوماسيتها في سورية. وما بين الخطين، وجدت أن المسار الثالث الذي يناسب الرؤية الروسية هو تركيب دبلوماسية متعددة الأطراف، لكن بعدد أقل بكثير من التشكيلة التي اتبعتها الأمم المتحدة، فاجترحت مسار آستانة، حيث حرصت فيه على حصر الأطراف الدولية، إضافة إلى نفسها مع إيران وتركيا، واستبعاد باقي الدول والحكومات المؤثرة. وضمن تلك الرؤيا، تعاملت مع المعارضة السورية الرسمية، على أنها كتل وشخصيات متباينة، وتفاعلت مع كل فريق على حدة، بعد أن عززت لدى الجميع أن العودة لموسكو أمر ضروري لا مفر منه للتوصل إلى حل في سورية.
هذه الدبلوماسية التي تم تنميتها ببطء وحرص من قبل الروس، كانت ممارسة سياسية جديدة على تاريخ العمل الروسي السياسي والدبلوماسي. وقد استطاع الكرملين بصبر مراكمة الخبرات ودراستها وتحليلها للتعامل مع أطياف قيادات المعارضة السورية، وكذلك للتعامل مع الدبلوماسية الدولية المنخرطة بالموضوع السوري. لكن فرض مسار دبلوماسي متعدد الأطراف تقوده روسيا لمواجهة خط الأمم المتحدة، بعد ثلاث سنوات من العمل السياسي، كان بحاجة إلى وجود روسي أقوى على الساحة السورية. وقد توصل الكرملين إلى هذه النتيجة في الوقت الذي كان به النظام الأسدي يصل إلى مرحلة التداعي الفوضوي الذي أخاف الدول الإقليمية والدولية؛ فكان التدخل الروسي العسكري الحاسم في 2015 مدعاةً لارتياح دولي وإقليمي، لأن أيًا منهم لم يكن مستعدًا لانهيار مفاجئ للنظام، من باب أن لا دولة متداخلة في سورية كانت تملك أوراق القوة الكافية للتحكم في مرحلة ما بعد السقوط. وكذلك كان التدخل الروسي العسكري إعادة إنعاش باللحظة الأخيرة لنظام الأسد وحليفه النظام الإيراني.
ومما زاد أيضًا في قبول التدخل العسكري الروسي، انطلاق الحملة الدولية ضد (داعش) في سورية، والتي ظهرت في سورية تحت أعين جميع الدول المتداخلة في سورية بمن فيهم روسيا ومخابراتها[7]؛ وإضافة إلى ذلك كان هناك ميل عند العالم الغربي للتخفيف من حدة التوتر والصدام مع روسيا، بسبب اجتياحها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ربيع العام 2014، الأمر الذي صعّد التوتر ما بين روسيا والغرب بسرعة كبيرة. لقد كان تصعيدًا حتميًا بالنسبة لكثير من الحكومات الأوروبية، بالرغم من أن بعضها لم يكن ميالًا لصدام حاد مع روسيا مثل ألمانيا وإيطاليا، مع وجود رغبة دائمة في الحد من التعاون الروسي الأوروبي من قبل دول أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا، وما بين الطرفين كان الموقف الفرنسي والبريطاني. أما بالنسبة إلى الإدارة الأميركية مع أوباما، فقد كان موقفها أقرب إلى ما يمكن تشبيهه بأبغض الواجب أمام التصعيد الروسي.
على المستوى الإقليمي، سعت روسيا لبناء علاقات ثلاثية الارتكاز، بحيث تكون روسيا نقطة اللقاء بين مختلف هذه المثلثات، وعبّرت عن ذلك دراسة حول السياسة الروسية في سورية منشورة لدى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى[8].
الشكل 2 خماسي الدبلوماسية الثلاثية الروسية في سورية
استطاعت روسيا عبر سياستها في سورية أن تجزّئ الاشتباك السياسي والدبلوماسي السوري والإقليمي بين الأطراف الفاعلة، لتصبح مركزًا محوريًا وضروريًا بين هذه الأطراف. لكنها مع ذلك لم تستطع فرض مركزيتها بشكل كبير بما يتعلق بالدور الأوروبي والأميركي.
اكتفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالوقوف على الحياد تقريبًا منذ العام 2015 على الأقل، وعدم معارضة السياسات الروسية بشكل جذري. فاكتفت الإدارة الأميركية بالتنسيق العسكري واللوجستي على الأرض في سورية، بما خص ما سُمي عملية قتال (داعش)، وأيضًا بوضع خطوط فاصلة تتمحور حول مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”. أما الدول الأوروبية، فقد تناغمت لحد كبير مع السياسة الأميركية عمومًا، ورفضت بإصرار الضغط الروسي لوضع قضية اللاجئين السوريين في أوروبا على طاولة المساومات مع الكرملين. ولعلنا نذكر جهود بوتين الحثيثة في 2018 لحشد دعم أوروبي للخطة الروسية في سورية، مقابل إعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، والتي قابلها رفض ألماني حاسم[1].
على مستوى المعارضة السورية، اتبعت روسيا سياسة ثلاثية أيضًا، سواء مع قادات المعارضة المسلحة أو السياسية، وذلك من خلال استخدام علاقاتها بدول الإقليم لضمان اتفاقيات جزئية صبّت بمحصلتها في مصلحة النظام الأسدي. واتبعت روسيا أيضًا سياسة العلاقات الثنائية المستقلة عن بعضها مع دول الخليج الفاعلة في سورية، بالرغم مما شاب علاقات روسيا بقطر في بداية الثورة السورية، واهتزازات الثقة ما بين روسيا والسعودية.
بكل الأحوال، اتسقت هذه السياسة مع تراجع الدور الخليجي المباشر في سورية منذ نهاية عام 2016، والذي ربما حصل بتأثير وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض. فلم يكن الملف السوري ملفًا شائكًا بين روسيا وبين دول الخليج العربي بعد 2020. وقد مكنت هذه السياسة الدبلوماسيةَ الروسية من تأسيس منهجية جديدة نسبيًا، مقارنة بتاريخ الدبلوماسية الروسية في التعامل مع الأزمات المشابهة وذات الأهمية القصوى بمنظور الأمن القومي الروسي.
ومع ذلك، لا بدّ من توضيح أن هذه السياسة، بالرغم من نجاحها الجزئي، لم تستطع تحقيق الأهداف الروسية المُخطط لها في سورية. وذلك يعود لجملة من الأسباب أهمّها:
أولًا، افتقاد روسيا للعلاقات الدولية اللازمة لفرض حلّ في سورية، وخاصة مستوى علاقتها بالغرب وحتى مستوى علاقاتها بتركيا ودول الخليج العربي. ففي سورية لا يمكن لروسيا، حتى بالتعاون مع إيران والصين، أن تفرض حلًّا بغض النظر عن شكله في سورية من دون دعم أميركي أوروبي واضح مباشر وقوي على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي الواقع، لم يؤدِ الدور الروسي في الأزمة السورية إلى تحسّن العلاقات الروسية الغربية، بل أدى إلى زيادة الشك والتباعد من قبل الحكومات الغربية.
ثانيًا، تمسك الكرملين وبوتين بتقليد روسي سوفيتي قديم ثبت فشله، بالرغم من كل المرونة والديناميكية التي أبدتها الدبلوماسية الروسية في مناح أخرى، وهو التمسك برجل روسيا في الدولة أو البلد المعني، مهما كان الثمن؛ فإصرار روسيا مثلًا على شخص رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وجماعته من سياسيين أوكرانيين، وعلى شخص رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وغيرهم من زعماء حلفاء، أدى إلى زيادة الصعوبات والتحديات التي تواجه روسيا.
وفي سورية، أدى تمسك بوتين ومعه النظام الإيراني بشخص بشار الأسد والدائرة الحاكمة في نظامه، إلى وضع سدّ منافذ كثيرة أمام السياسة الروسية، كان يمكنها المناورة خلالها للتوصل إلى حل لا يتعارض مع مصالحها.
ثالثًا، افتقار روسيا -دولة وحكومة- إلى خبرات التخطيط المتوسط وبعيد المدى، حتى داخل روسيا نفسها، وإلى الإمكانيات الاقتصادية اللازمة لانتشال دولة حلّ بها كل هذا الدمار من مشاكلها. فضلًا عن عجز نظام الأسد ذاتيًا عن استعادة سورية وإعادة بنائها[2].
رابعًا، بالرغم من اتفاق الكرملين مع النظام الإيراني استراتيجيًا على صيانة تحالفهما، الذي هو حلف الضرورة كما بينّا سابقًا، فإن الفريقين لم يملكا نظرة وأهدافًا واحدة في سورية. فلا يمكن مثلًا تشبيه تناسق روسيا وإيران في سورية، بتناسق عمل الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية ودول الخليج في العراق.
خامسًا، عدم وجود ثقة بين الكرملين وبين حكومة الرئيس طيب أردوغان، بالرغم من العلاقات المتينة بين البلدين، ومن تفاهمهما على أن الصدام بين روسيا وتركيا ممنوع عليهما بحكم حقيقة أن أي صدام كبير سيؤدي إلى خسارة حتمية للطرفين. هذه الثقة المهزوزة ظهرت في سورية وفي ملف أذربيجان وأرمينيا، وأيضًا في الملف الأوكراني.
إذًا، لا يمكن أن ندعي أن السياسة الروسية في سورية حققت نصرًا سياسيًا للكرملين، وكذلك لا يمكن الادعاء بأنها فشلت. وعلى ما يبدو أن بوتين وفريقه يملكون الصبر الكافي لمتابعة سياستهم في سورية إلى آخر ما يستطيعون، ما دامت سورية باقية على أولويات مصالح روسيا القومية.
الدروس التي استفادتها روسيا من سورية على المستوى العسكري
كما ورد في المقدمة، فقد كانت سورية، إضافة إلى الأهداف الروسية الاستراتيجية الكبرى، ساحةً لاختبار التطويرات الكبيرة التي شهدها الجيش الروسي، خاصة بعد حرب جورجيا 2008 التي أظهرت ضعف الأداء العسكري للجيش الروسي[3]. فبدأ التدخل الروسي بتوجيه ضربات محددة مدروسة مسبقًا، وباستخدام سلاح الجو والصواريخ، واعتمادًا على تجميع المعلومات وتحليلها. فركز الجيش الروسي على تدمير القدرات القتالية للفصائل المستهدفة، وتقطيع طرق التواصل أو الدعم، ولم يستعجل الروس في عمليات استعادة الأرض. وربما هنا يمكن ملاحظة سبب الخلافات التكتيكية بين نظام الأسد والحركة الإيرانية عبر ميليشياتها وبين الخطة الروسية.
لقد كان واضحًا أثر التكتيكات التي استخدمتها قوات التحالف في عاصفة الصحراء 1991 على التكتيكات التي اتبعتها روسيا في سورية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة والحرب الإلكترونية والمعلومات والتنسيق العالي بين مختلف أنواع الأسلحة، الجوية والسفن والغواصات العسكرية والبرية. وقد عبر عن ذلك المقدم تيموثي توماس، من الجيش الأميركي، بدراسة مفصلة عن الجيش الروسي[4]، من حيث أهمية الفترة الأولى للعملية العسكرية وشمولية عمليات جمع المعلومات من خلال استثمار تقنيات المعلومات الحديثة، والتنسيق العالي بين القطع العسكرية؛ إذ كتب: “سيكون استخدام الذخائر الموجهة بدقة، والروبوتات، والمركبات الجوية غير المأهولة، والأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة، هي الأساليب الرئيسية الجديدة للاشتباك مع العدو”. ولم تمرّ العمليات الروسية بدون أخطاء كبيرة وصغيرة وخسائر غير محسوبة، مثل فشل بعض صواريخ (كاليبر كروز) التي أطلقت من أسطول بحر قزوين في البداية، لكن كثيرًا من هذه الأخطاء صُححت لاحقًا لتثبت جدارة عالية.
ومن ناحية ثانية، يشير أيضًا توماس، نقلًا عن رئيس الأركان الروسي، إلى وضع خيار استخدام الشركات العسكرية الخاصة في المعارك عند الحاجة. وهذا أيضًا ما مارسته روسيا في سورية وأيضًا في ليبيا، حيث لم تشتبك القوات الروسية البرية بشكل مباشر وحقيقي في الحرب الدائرة، لا في سورية ولا في ليبيا.
لقد كانت سورية فعلًا الساحة الأولى لاختبار التطويرات الضخمة على العسكرية الروسية، وربما كانت هذه الاختبارات هدفًا ثانويًا للتدخل العسكري الروسي في سورية، لكنها بالتأكيد لا تكفي لتكون دافعًا أساسيًا لذلك، كما يشاع كثيرًا في قراءة الأزمة السورية.
النتائج التي توصلت لها روسيا بعد 7 سنوات من غزو سورية
لعل النتيجة الأهمّ بالنسبة للحركة الجيوسياسية الروسية كانت أنها استطاعت الاقتراب كثيرًا من الحركة الجيوسياسية الغربية والأميركية، وتعلمت من خلالها كيفية إدارة أزمات معقدة خارج أراضيها، بمواجهة تضارب مصالح مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي. واستطاعت في الوقت نفسه التحقق من صدقية المؤشرات الكثيرة الواردة حول عدم رغبة صناع القرار السياسي الغربي في التدخل الحاسم في سورية، خصوصًا بعد الاختبار الأولي في اجتياح جزيرة القرم؛ فالقفز إلى سورية من القرم كان بعد تجاوز الاختبار الأول.
والنتيجة الثانية أنها فرضت نفسها كطرف في ما يُسمى “الحرب على الإرهاب” التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية؛ فعلى الرغم من أن غالبية عملياتها لم تستهدف (داعش) التي هي أكبر وأخطر فصيل إرهابي إسلامي في سورية، من وجهة النظر الغربية، فإنها استندت إلى أن وجود حركة على الأرض مترافقة مع حملات إعلامية كبيرة تغطي ما يحصل حقيقة على الأرض سيؤدي إلى فرض الكذبة، مهما كبر حجمها.
بايدن يقلل من خيارات بوتين في سورية وأوكرانيا
بعد خسارة ترامب لانتخابات 2016 الأميركية، خسر بوتين صديقًا وحليفًا أساسيًا في الإدارة الأميركية، كان يمكن له -لو فاز بالانتخابات- أن يدعم خطوات بوتين في سورية للخروج بالنتائج التي رسمها الكرملين لتدخله في سورية، إضافة إلى إطلاق حملته تجاه أوروبا الشرقية، من خلال إجبار أوكرانيا سياسيًا على الرضوخ للسيطرة الروسية. لكن مع قدوم جو بايدن[5]، وهو الذي لم يخفِ نفوره من بوتين خلال مرافقته لأوباما كنائب له[6]، انقلبت السياسة الأميركية الخارجية ضد ما كان بوتين مستعدًا له.
كان من الواضح أن إدارة بايدن ستركز على الملفات الداخلية المتأزمة نتيجة وباء كورونا، وخارجيًا ستركز على إعادة ترميم العلاقات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأميركية التي كاد ترامب أن يفسدها، وعلى معالجة الملف الصيني الذي ما زال يمثل الأولوية الكبرى لكل الإدارات الأميركية. وكانت البداية بمكالمة هاتفية متأخرة عن التقليد الأميركي مع الرؤساء الجدد، وأيضًا جافة وخلافية[7]. فالزعيمان لم يكونا على أحسن ما يرام سابقًا، ولا مع بداية رئاسة بايدن.
وبعد سنة من ولاية الإدارة الجديدة، تحقق عند بوتين أن الملفات العالقة مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية ستبقى مُجمَّدة، وأهمها العقوبات الاقتصادية القاسية التي كلفت الاقتصاد الروسي الكثير من الخسائر، إضافة إلى ملف أوروبا الشرقية وحلف الناتو، وإلى الملف السوري. وبهذه الحالة، فالولايات المتحدة الأميركية لا تخسر كثيرًا بسبب تلك العقوبات، على حين أن الخسائر الروسية الاقتصادية كبيرة جدًا، فضلًا عن التأثير السلبي جدًا على شعبية بوتين داخل روسيا المتدهورة منذ سنوات، بسبب تراجع الأداء الاقتصادي، خاصة بعد أزمة كورونا 8.
كنت في دراسة سابقة قد فصّلت أسباب واحتمالات الأزمة الأوكرانية الروسية[9]، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الأزمة هي قفزة للأمام، قام بها بوتين لوضع الأميركيين والأوروبيين تحت ضغط كابوس اشتعال الحرب في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إجبارهم على الجلوس مع الكرملين على طاولة المفاوضات. الطاولة التي لن تشكل أوكرانيا أهم بنودها، بل ستكون منصة لمطالب روسية بإعادة النظر بكامل سياسة الحلف الغربي تجاه روسيا ومصالحها.
بعد التجربة الطويلة لروسيا في سورية، يبدو أن بوتين أصبح أكثر ثقة في اتباع سياسة شفير الهاوية، لكن مع وضع خطط وسيناريوهات سياسية وعسكرية تبدو له أنها كافية لتجنب السقوط في الهاوية. فمن ناحية يعتمد بوتين كثيرًا على التأثير الروسي داخل أوكرانيا، وخاصة في الأقاليم الشرقية، حيث يمكنه ممارسة تلك السياسة في سورية لكن بشكل مقلوب نوعاً ما.
ففي سورية، يدَّعي الكرملين أنه دخل سورية بناءً على طلب “الحكومة الشرعية” السورية، أي نظام الأسد، التي تواجه تشكيكات بشرعيتها من قبل كثير من حكومات العالم؛ ثم تعامل مع المعارضة السياسية والعسكرية من موقف الاستناد إلى حلفه مع النظام الأسدي في دمشق. أما في أوكرانيا، فالكرملين يهدد بالدخول العسكري المباشر رغمًا عن الحكومة الشرعية الأوكرانية التي يعترف بها كل العالم، مرتكزًا إلى حلف مع معارضة أوكرانية تطالب بالانفصال أو شبه الاستقلال عن حكومة كييف.
أما عسكريًا، فمن نوعية الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، وبناء على ممارساتها في سورية، فالواضح أن الجيش الروسي سيلجأ إلى التكتيكات نفسها في أوكرانيا، إن حصلت مجابهة عسكرية مع أوكرانيا. أي البدء بضربات محدودة موجهة ومركزة على أهداف استراتيجية في الداخل الأوكراني، مما سيزيد من إثبات جدية التحركات الروسية أمام الغرب. وسينتقل بعدها بالتدريج للتصعيد العسكري، عبر الموالين الأوكرانيين لروسيا في الأقاليم الشرقية، قبل أن يقرر إدخال الجيش الروسي البري بمواجهات مباشرة مع الجيش الأوكراني، خاصة أن الجيش الأوكراني، على تواضع عدده وأسلحته، مجهّزٌ نسبيًا بأسلحة غربية متقدمة، خاصة المضادة للدروع والطائرات الموجهة عن بعد.
لكن هل يستطيع بوتين فعلًا التحكم في السيناريوهات، كما حصل في سورية، من دون أن يكون هناك تصعيد عسكري وسياسي خارج عن السيطرة؟ هنا، يكمن الفرق الأساسي بين سورية وأوكرانيا، إذا قارنّا الحالتين من وجهة نظر التدخل الروسي. في سورية كان هناك إجماع إقليمي ودولي على منع خروج نيران الأزمة السورية إلى خارج حدود سورية، مهما اختلفت مصالح الدول الفاعلة بالأزمة السورية.
أما في أوكرانيا، فهذا الإجماع غير مطروح أساسًا ضمن تنسيق بين مختلف الأطراف، وهو أكبر بكثير من إمكانيات روسيا السياسية والدبلوماسية. وعلى الرغم من أن كلًا من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي يسعيان لتقليص الأزمة قدر الإمكان، فإنّ التحكم في الأزمة سيكون صعبًا جدًا عليهم، وهم واقفون خارج الحدود الأوكرانية عسكريًا، فضلًا عن وجود توتر سياسي قديم وعميق بين روسيا وبولندا، الدولة الأكبر الجارة لأوكرانيا من طرف الناتو؛ وعن التوتر السياسي أيضًا بين أوكرانيا وبيلاروسيا حليف روسيا الأهم في شرق أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، ومما جرى في سورية، حيث لم يحسب العمل العسكري الروسي حساب الضحايا المدنيين، فإن أي كارثة إنسانية كبيرة في أوكرانيا نتيجة الحرب ستؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات بشكل كبير، فضلًا عن أنها ستؤدي إلى موجة لجوء ضخمة باتجاه أوروبا الغربية؛ والاتحاد الأوروبي ما زال يهتز تحت نتائج موجة اللجوء الكبيرة في عام 2015، التي استغلها اليمين الغربي المتطرف بشكل مربح جدًا ليعزز قوته السياسية في غالبية دول الاتحاد الأوروبي. بالواقع، هنا لا بد من الإشارة إلى العلاقة المتينة بين بوتين وبين هذا اليمين المتطرف، والتي توازت مع العلاقة المتينة ما بين بوتين وترامب، حيث شكّل فوز الأخير برئاسة الولايات المتحدة الأميركية ما بين 2016 و2020 أكبر دعم لصعود اليمين الأوروبي المتطرف.
خاتمة
بالرغم من أن المؤشرات تقول إن الصدام العسكري ممكن في أوكرانيا، فإن الحركة الغربية الحاسمة التي تقودها الولايات المتحدة ستُجبر بوتين والكرملين على إعادة النظر؛ ذلك أن العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها الإدارة الأميركية هذه المرة قد تؤدي إلى خسائر لم يشهدها الاقتصاد الروسي سابقًا، ولا يمكن للكرملين المراهنة على دعم صيني هنا؛ فالصين ليست متحمسة لزيادة التوتر الأوكراني الروسي، خاصة أنها تملك علاقات طيبة مع كييف. ومن ثَم، لا يمكن أن يكون هناك حلّ جذريّ على المدى المنظور، وإن تمّ التوصل قريبًا إلى تهدئة التوتر أو إلى نوع من التوافقات السياسية، وسيبقى خطر اشتعال الأزمة قائمًا، وسيغيّر الكثير في سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
لقد دفع السوريون ثمن حرب ليست حربهم، وثمن صراع دولي كبير ومعقد فوق أرضهم، وكان الرابح حتى الآن هو نظام الأسد، إذ ظل محافظًا على سلطته بحماية روسية إيرانية. والآن مع تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، عاد هذا الصراع ليعيد الاشتعال مرة ثانية في ظروف أشد تعقيدًا. وفي الناحية الأوكرانية، يعاني الأوكرانيون الحالة نفسها، حيث تشتد أسباب الحرب على حدودهم، ولأهداف أبعد من أرضهم، لكن على حساب وطنهم.
[1] “دراسات في الهجرة واللجوء روسيا واللاجئون السوريون، فاقد الشيء لا يعطيه” – علاء الخطيب – 01/08/2018
[2] “هل سورية بين خيارين فقط: النظام أم الإسلاميون؟” – علاء الخطيب – 01/2016
[3] “القوات الروسية العسكرية تتألق بعد عقد من الإصلاحات، الناتو يجب أن يتقدم” – إيكونوميست – 07/11/2020
[4] :” الطبيعة المتطورة لطريقة الحرب الروسية” – المقدم تيموثي توماس من الجيش الأمريكي – عدد شهري 07 و08 لعام 2017 – دورية مليتاري ريفيو
[5] “كيف ستكون سياسة أمريكا مع بايدن في الشرق الأوسط؟ من هم الزعماء الفرحون ومن هم القلقون مع قدوم بايدن؟” – علاء الخطيب – فيديو 26/01/2021
[6] “نائب الرئيس الأمريكي بايدن يقول ان بوتين بلا روح” – رويتر – 21/07/2014
[7] “بايدن بأول اتصال يواجه بوتين” – فوكس نيوز – 26/01/2021
[8] “القيصرية الروسية هل تعود للتمدد؟ طبول الحرب على حدود أوكرانيا” – علاء الخطيب – 16/01/2022
[1] “روسيا والصين وإيران حلف مستمر” – علاء الخطيب – 15/12/2016
[2] ” سوق الغاز الطبيعي وعلاقته بالمسألة السورية” – علاء الخطيب – 09/05/2018
[3] ” الصراع الدولي والأزمة السورية: الأسباب والنهايات” – علاء الخطيب – 01/09/2018
[4] “الشعب الإيراني يهدم أساطير المؤامرات” – علاء الخطيب – 02/01/2018
[5] “لماذا تدعم الصين النظام الأسدي؟” – علاء الخطيب – 13/11/2019
[6] كتاب “حرب بوتين في سوريا. السياسة الخارجية الروسية وثمن الغياب الأمريكي” – آنا بورشفسكايا – 04/11/2021 – Bloomsbury Publishing
[7] ” تصدير الجهاديين من روسيا” – علاء الخطيب – 17/03/2016 – تقرير مجموعة الأزمات الدولية.
[8] “الدبلوماسية الثلاثية: معاينة الاستراتيجية الروسية في سوريا” – آنا بورشيسكيا، أندريو تابلر – معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
„Triangular Diplomacy: Unpacking Russia’s Syria Strategy” – Anna Borshchevskaya, Andrew J. Tabler – 07/07/2021
[1] إنترفاكس – 03/02/2019
[2] سي بي سي نيوز – 25/04/2005
[3] محور الباسيفيك الأمريكي – دافيد بتلمان – 2012
طباعة
مركز حرمون
—————————-

الصراع الدولي حول أوكرانيا وعلاقته بسورية؟/ محمود الحمزة
منذ أشهر، تجذب أوكرانيا اهتمام العالم، وأصبحنا نسمع كل ساعة أسماء رؤساء، مثل بوتين و زيلينسكي وبايدن مع أسماء وزراء خارجيتهم. وبلغ التصعيد الإعلامي حدًّا غير مسبوق إلا في فترة الحرب الباردة أو حتى الساخنة؛ وقد صرّح الغرب، على لسان رئيس أكبر دولة وهو بايدن، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا سيبدأ في 16 شباط/ فبراير، وقد صدق البعض بايدن، واعتقدوا أن لديه معلومات استخباراتية دقيقة، خاصة أن هناك تقريرًا اقتصاديًا دوليًا قال، في 9 شباط/ فبراير، إن كمية الغاز المخزنة في أوروبا لا تكفي لأكثر من أسبوع واحد فقط، وإن روسيا تمتنع عن تزويد تلك المخازن الأوروبية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي (تصل نسبته إلى 40 % من احتياجات أوروبا). وتم التصريح عن مواعيد جديدة للحرب، وبعدها أصبح الموعد مفتوحًا، لكنه مؤكد حسب المصادر الاستخباراتية والرسمية الغربية.
ومن جهة أخرى، ينفي الروس بشكل قطعي أن لديهم أي نية لغزو أوكرانيا. ولكن التصريحات شيء، والعمل على الأرض شيء مختلف. فلو اقتصرت روسيا على مناوراتها على الحدود الأوكرانية الشرقية، لقلنا إنها لا تنوي غزو أوكرانيا، ولكن ما معنى المناورات المشتركة مع بيلاروسيا على الحدود الشمالية لأوكرانيا، والمناورات الاستراتيجية والمناورات البحرية في كل مكان؟! إن ذلك كله يخلق أجواء للحرب.
لمحة تاريخية عن أوكرانيا وعلاقتها مع روسيا:
كلمة أوكرانيا تعني “على الأطراف”، أي إن أوكرانيا كانت أراضي واقعة على أطراف الإمبراطورية الروسية، وخضعت في فترات مختلفة لإمبراطوريات أخرى مثل البولوندية والليتوانية وغيرها. ولم تظهر أوكرانيا كدولة بحدودها الحالية إلا ضمن الاتحاد السوفيتي بعد 1922.
ويجدر الذكر أن عاصمة أوكرانيا -مدينة كييف الخضراء- كانت أول عاصمة للدولة الروسية القديمة، وفيها اعتنقت المسيحية عام 988 م، على يد الأمير فلاديمير الذي تحالف مع البيزنطيين، وجاء إليه قسيسان من سورية البيزنطية، وهما ميفوديوس وكيريليوس، وأسسا الأبجدية السلافية التي تُعرف حاليًّا بالكيريلية، بهدف إيجاد لغة لنشر الإنجيل بها. والذي علّم الروس المسيحية في كييف هو قسيس سوري اسمه ميخائيل.
وفي 1954، أعطى الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف، وهو أوكراني، شبه جزيرة القرم لجمهورية أوكرانيا السوفيتية. وكتب الرئيس بوتين مقالة حول أوكرانيا، أكد فيها أن أوكرانيا أصلًا “ليست دولة، ولا يمكن لها أن تبقى بدون العلاقة مع روسيا”، واعتبر أن قيادتها أصبحت ألعوبة بيد الغرب. وأكد أيضًا أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يعني إعلان الحرب من قبل الغرب على روسيا. وكذلك كتب دميتري ميدفيدف مقالة، منذ فترة قريبة، رأى فيها أن لا فائدة من الحوار مع قادة أوكرانيا ورئيسها، واتهم الرئيس الأوكراني فزلزديمير زيلينسكي بأنه يريد أن يكسب شعبية، ويخشى من التصريح عن قوميته (اليهودية)، وينسى اضطهاد النازية (لليهود).
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ظلت القيادة الروسية الحالية ترى أن الجمهوريات السوفيتية السابقة هي الفضاء الحيوي والجيوسياسي لروسيا، وخاصة أوكرانيا وبيلاروسيا السلافيتين والمسيحيتين الأرثوذكسيتين (علمًا أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية انفصلت بموافقة البطريركية في إسطنبول، وكان ذلك موقفًا مؤلمًا للبطريركية الروسية التي تعتبر نفسها روما الثالثة ووريثة بيزنطة والمسؤولة عن الأرثوذكس بالعالم).
ولكي نفهم حقيقة العلاقة بين موسكو والدول السوفيتية السابقة، علينا أن نعلم أن بوصلة السياسة الروسية المعاصرة هي المصالح الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية، وأن ليس لديها أيديولوجيا واضحة، كالأيديولوجيا الشيوعية في العهد السوفيتي، وأن المهيمن في روسيا هي طبقة الأوليغاركية وأجهزة الأمن والجيش، وليس المؤسسات. أما القرارات الأساسية في الدولة، فهي مرتبطة بالرئيس، لأنه هو صاحب القرار في البلد، ولا أحد غيره.
وهذه النخبة المالية ورجال الأعمال يسعون للهيمنة على الدول المجاورة، من خلال شراء شركات النفط والمصارف والسيطرة على الحياة الاقتصادية وبعدها السياسية. وهذا ما شهدناه في العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، حيث بقي الرئيس لوكاشينكو لسنوات طويلة يعاند روسيا، وينظر إلى الغرب بعينٍ، وإلى الشرق (أي روسيا) بعين أخرى، حتى جرت احتجاجات شعبية عارمة في عام 2021، ضد تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، التي لم تكن لصالحه، ولكن تدخل الاخ الأكبر – بوتين، بإرسال دعم مالي وعسكري، ساعد لوكاشينكو في استعادة أنفاسه، وفي المقابل، يبدو أنه سلّم بيلاروسيا إلى الكريملين. حيث تنفذ روسيا اليوم مناورات عسكرية على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، وتؤكد تصريحات الرئيسين أنهما يشتركان في الدفاع عن أمنهما ضد الضغوطات الغربية.
بدأ الصراع بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2004، عندما قامت الثورة البرتقالية التي سماها الروس “الثورات الملونة”، واعتبروها من صنع الغرب، وتعدها موسكو خطرًا على روسيا نفسها، لأن القيادة الروسية تقف ضد الثورات بشكل مبدئي.
وفي عام 2013، وقف الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش، وهو رجل أعمال موالٍ جزئيًا لروسيا، ضد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فخرج آلاف المعارضين لموقفه، واستمرت الاحتجاجات حتى شهدنا سيطرة تلك القوى على السلطة في 2014، حيث هرب يانوكوفيتش من أوكرانيا إلى روسيا، وأصبحت أوكرانيا رسميًا موالية لأوروبا الغربية ومعادية لروسيا. والمشكلة أن المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا فيها نسبة من الروس. فسارعت موسكو، وسيطرت على القرم، وسلّحت الانفصاليين في إقليمي لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، ونسبة الروس فيهما تزيد على 40%، علمًا أن منطقة الدونباس غنية بالفحم (منطقة الدونباس والمناطق الغربية من روسيا كانت تسمى قبل قرون “روسيا الصغرى”، ولكن الاسم لم يعد يستخدم بعد تشكل الدولة الأوكرانية في القرن العشرين).
من المشكلات الكبرى التي برزت بعد أحداث 2014 في أوكرانيا، موضوع خطوط الغاز التي تمر من أوكرانيا، وتنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا وخاصة ألمانيا. وقد عملت موسكو للتخلص من المشكلات مع أوكرانيا، التي تختلف معها سياسيًا، على إنشاء خط جديد سمي بـ (التيار الشمالي-2)، يمرّ ببحر البلطيق إلى ألمانيا مباشرة، وأنجز المشروع في نهاية 2021، بالرغم من الضغوطات الأميركية لمنع إنجازه، ولكن ألمانيا لم تسمح بتشغيله حتى اليوم، بسبب الخلافات التي نشهدها حول أوكرانيا.
جوهر الخلاف الروسي الغربي:
عندما وافق الرئيس ميخائيل غورباتشوف، في نهاية الثمانينيات، على سحب الجيش السوفيتي من ألمانيا الشرقية وحلّ حلف وارسو، وعَدَه الأميركان شفهيًا -كما يقول الروس- بأن حلف الناتو لن يتقدم إلى الحدود الغربية لروسيا. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 1991، انضمت جمهوريات البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا) إلى الناتو.
وبعد 2014، أصبحت أوكرانيا مرشحة بقوة للانضمام إلى الناتو، فاعتبر الروس ذلك خطًا أحمر وخطرًا على أمنها القومي، لا يمكن قبوله. ولا شك أن أوكرانيا تعني الكثير لروسيا؛ فهي ليست مجرد موقع جغرافي جيوسياسي مهم، وإنما هي دولة شقيقة لروسيا، من ناحية التاريخ واللغة والقومية والدين، وأوكرانيا هي الرئة التي تتنفس منه روسيا باتجاه أوروبا، وبحسب رأي مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق بريجينسكي، فإن “روسيا بدون أوكرانيا ليست دولة عظمى”.
ونشير أيضًا إلى اتفاقية مينسك عام 2015 التي وقعتها روسيا وأوكرانيا (الرئيس بوروشينكو) وفرنسا وألمانيا، والتي نصت على اعتبار خصوصية لإقليمي لوهانسك ودونيتسك في الدستور، وضرورة وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات، ثم تسليم الحدود الأوكرانية الروسية إلى السلطات الأوكرانية. ولكن الرئيس زيلينسكي اعتبر هذه الاتفاقية إهانة لأوكرانيا، ولذلك حاولت السلطات الأوكرانية أكثر من مرة استعادة السيطرة عسكريًا على إقليم دونباس.
والذي أثار حفيظة الكريملين هو الحديث عن توسع عسكري للناتو في أوكرانيا، والنقاش حول انضمام أوكرانيا للناتو؛ حيث طلبت روسيا من الناتو وأميركا أن يقدّموا لها ضمانات أمنية، منها عدم التوسع بالقرب من حدود روسيا، وعدم ضم أعضاء جدد للناتو من الدول المجاورة لروسيا، مثل أوكرانيا وجورجيا (علمًا أن النظام الداخلي للناتو ينصّ على عدم قبول أي دولة في عضويته، إذا كان لديها مشاكل انفصالية أو حدودية)، وكذلك العودة إلى ما قبل 1997، وإلغاء انضمام كل الدول الأوروبية الشرقية التي انتسبت إلى الحلف منذ ذلك التاريخ. ولكن الغرب عمومًا ردّ بالرفض على المقترحات الروسية. وترك الطرفان الباب مفتوحًا لمفاوضات دبلوماسية، وهي تجري بشكل مستمر دون جدوى، لأن كلا الطرفين الروسي والغربي (الأوكراني) لا يتنازل قيد أنملة عن مواقفه وثوابته.
وعبّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن قلقه وتذمره من الموقف الغربي، لأنه برأي القيادة الأوكرانية أولًا يخلق الهلع بين الأوكرانيين، بالحديث عن قرب غزو روسيا لأوكرانيا، ويؤدي إلى هروب الاستثمارات من أوكرانيا، بسبب التخوف من اندلاع الحرب، وأخيرًا لأن الناتو وأميركا يقولون إنهم لن يتدخلوا عسكريًا للدفاع عن أوكرانيا، وإنما سيقتصر دعمهم على تقديم المساعدات العسكرية والمالية، وكذلك يهددون باتخاذ عقوبات قوية غير مسبوقة ضد روسيا.
تطورات الأزمة الأخيرة:
منذ أشهر، نشهد حملة إعلامية غير مسبوقة، وخاصة من الدول الغربية، بأن روسيا تنوي غزو أوكرانيا لمنع انضمامها للناتو، وتطالب بسحب القوات الروسية الموجودة على الحدود الأوكرانية، وقد بلغ عددها نحو 190 ألف عسكري، إضافة إلى المناورات العسكرية البحرية والجوية والبرية بمحاذاة أوكرانيا من الشرق في روسيا، ومن الشمال في بيلاروسيا، ومن الجنوب في القرم، إضافة إلى المناورات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وفي بحر قزوين ومناطق مختلفة من العالم، اختتمت منذ يومين بتدريبات على أسلحة استراتيجية، استخدمت فيها صواريخ “فرط صوتية” تستخدم لحمل الرؤوس النووية.
وأعتقد أن الهدف من كل هذا الاستعراض العسكري الروسي عالي المستوى هو إبراز القدرات العسكرية الروسية، وإبلاغ الغرب بأن روسيا قادرة على الرد ومجابهة أي ضغط خارجي. ولكن تلك المناورات العسكرية تركت انطباعًا واسعًا في العالم بأن روسيا بالفعل تريد غزو أوكرانيا، التي لا يمكن أن تهدد روسيا لعدم وجود تكافؤ بالقدرات العسكرية، إضافة إلى أن الناتو لا ينوي التدخل إلى جانب أوكرانيا، وسيكتفي بتقديم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا. ويهدد الغرب روسيا باتخاذ عقوبات اقتصادية غير مسبوقة مدمرة وخطيرة جدًا، مثل قطع النظام المالي العالمي “سويفت” عن روسيا، وكذلك اتخاذ عقوبات بحق شركات مالية وأشخاص مقربين من بوتين. وقد شهدنا تضامنًا سياسيًا غربيًا غير مسبوق، أعرب عنه كبار المسؤولين الغربيين في مؤتمر ميونيخ للأمن، في تهديد روسيا بالعقوبات القاسية، وأن الغرب سيتخذ موقفًا موحدًا ضدها، علمًا أن الأوروبيين هم متضررون إلى جانب أوكرانيا وروسيا، وأن المستفيد الوحيد هو الولايات المتحدة.
وبالرغم من الاتصالات والزيارات لكبار القادة الغربيين، ومنهم وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، فإن موسكو لم تتلق ما يرضيها وهو التعامل بجدية -كما يقول الكرملين- مع طلباتها بالضمانات الأمنية.
ويستمر التصعيد السياسي والإعلامي والميداني، ويبدو أن الهوة كبيرة بين أطراف النزاع، وخاصة بعد انطلاق القتال في إقليم الدونباس، وترحيل المدنيين من هناك إلى روسيا، واستمرار المناورات العسكرية الاستراتيجية في بيلاروسيا ومناطق أخرى، وكل ذلك يخلق شعورًا بقرب نشوب حرب على الجبهة الأوكرانية لن يخسر منها إلا الشعب الأوكراني والروسي، مقابل إرضاء العنجهية السياسية والاقتصادية والعسكرية لقادة الدول الكبرى، وفي مقدمتهم روسيا وأميركا.
وفي ما يخص الغاز الطبيعي الروسي المصدّر إلى أوروبا، فإنه مهدد بالانقطاع في حال نشوب حرب، وقد صرّح قادة غربيون، ومنهم رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنهم جاهزون لاستبدال الغاز الروسي باستيراد غاز من دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط ودول أخرى.
والحقيقة أن الامتناع عن استيراد الغاز الروسي سيشكل كارثة حقيقية لروسيا ولأوروبا، وخاصة لألمانيا التي تستورد 30% من صادرات الغاز الروسي. وقد صرّح مسؤول ألماني كبير بأن الصناعة في ألمانيا ستصاب بالشلل إذا توقف الغاز الروسي. وهنا تكون نتائج المفاوضات حول النووي الإيراني مهمة جدًا، لأنها قد تنعكس على الصراعات القائمة، فإذا اتفقت إيران والغرب على إحياء الاتفاق، فستدخل إيران إلى سوق الغاز، وستشكل خطرًا على روسيا.
التصعيد في أوكرانيا والعلاقة مع سورية:
أحد أهم الأهداف الروسية بالتدخل العسكري في سورية عام 2015 جاء بعد فشل روسيا في فرض موقفها على الغرب في أوكرانيا (2014)، ولذلك سعت موسكو لاستخدام تدخلها العسكري للحفاظ على نظام الأسد أولًا، ولكي تنتزع اعترافًا غربيًا بأنها شريك وندّ في القضايا الدولية. وهذا استمرار لموقف الرئيس بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، عندما أعلن أنه لن يقبل بسياسة القطب الواحد، وأن روسيا ستدافع عن مصالحها.
وقد جاءت زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منذ أيام إلى سورية، في خضم التوتر حول أوكرانيا، مفاجأة لكثيرين، وذلك بهدف الإشراف على المناورات البحرية الكبيرة التي شاركت فيها عشرات السفن الحربية والصواريخ فرط صوتية والطائرات الحديثة وآلاف الجنود. وكان ذلك دليلًا واضحًا على أن موسكو ترسل رسالة إلى الغرب بأنها تسيطر على البحر المتوسط، منطلقة من قواعدها العسكرية في سورية في حميميم وطرطوس، وأن صواريخها تطال أوروبا الجنوبية، وأرادَت موسكو أن تبيّن للعالم أنها تستطيع أن تصل إلى أماكن بعيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقًا من قاعدة حميميم في سورية.
وكان لقاء الوزير الروسي مع الأسد في قاعدة حميميم، بعد أن انتظره الأسد ساعات عدة، إشارة إلى أن هناك توجيهات من بوتين إلى الأسد في موضوع محاربة (داعش) والتي نشهد تجهيزات كبيرة من قوات النظام وحلفائه تدعي أنها لمجابهة (داعش). ولنتذكر أن بيان مفاوضات آستانة الأخير ركّز في جزئه الأكبر على محاربة الإرهاب في سورية.
وبالطبع، لو نشبت الحرب في أوكرانيا، لانشغلت روسيا قليلًا عن الملفّ السوري، ولكنها لن تتراجع عن موقفها السياسي، لا في أوكرانيا ولا في سورية، فأجواء الصراع ستدفع موسكو إلى التمسك أكثر بموقعها في سورية وببقاء بشار الأسد في السلطة، علمًا أنّ الوضع في سورية مختلفٌ في التعامل بين الروس والأميركان؛ ففي حين تنسق موسكو وواشنطن، ومعها تل أبيب، بشكل قويّ في سورية، فإنهم يتصارعون في أوكرانيا لدرجة تكسير العظام.
—————————–
الغزو الروسي لأوكرانيا من منظار سوري
مما لا شك فيه أن التاريخ الذي يجمع روسيا وأوكرانيا هو تاريخ قائم على الوحدة الاقتصادية وإلى حدّ كبير الوحدة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية خصوصاً بعد ثورة أكتوبر 1917، ويجمع المؤرخون والباحثون على أن روسيا بلا أوكرانيا ستفقد امتدادها إلى البرّ الأوربي والذي تحتاجه في كل مناحي حياتها الاقتصادية والسياسية.
وإذا كان تفاهم غورباتشوف- بوش الأب عام 1989 قد قاد إلى الوحدة الألمانية وبداية انفصال دول حلف وارسو عن الاتحاد السوفييتي، فإنه بدون شك، قد شكل بداية ابتعاد أوكرانيا عن الأخت الكبرى- روسيا- وبداية الاقتراب التدريجي إلى دول أوربا الغربية وصولاً إلى طلب الانضمام إلى حلف الناتو. هنا، في فترة رئاسته الثالثة، يقف فلاديمير بوتين لاستعادة الإرث السوفييتي المهدور منذ 1991م ويعمل بكل جدّ لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية ولو أدى ذلك إلى الدخول من جديد في حقبة حرب باردة أو حتى ساخنة في بعض المناطق. ويبدو أن بوتين قد حسم أمره وبدأ الهجوم العسكري على أوكرانيا.
بينت أحداث 2014 أن الغالبية الساحقة للشعب الأوكراني ترغب الانضمام إلى الغرب الديمقراطي والابتعاد عن الشمولية الروسية. ومن تلك اللحظة وضع بوتين استراتيجية حازمة لإقامة نظام موالي لروسيا فغزا القرم وضمها إلى روسيا، لتحجيم أوكرانيا.
لا شك أن أصل الأزمة بين الدولتين يعود إلى اعتبار نظام بوتين الدولة الأوكرانية صنيعة ثورة أكتوبر وأن “فلاديمير لينين” مؤسس الاتحاد السوفيتي قد أعطى أوكرانيا الأرض والاقتصاد وهيكلية الدولة على حساب روسيا- الوطن الأم- وقد آن الأوان لتصحيح هذا الخطأ التاريخي. لكن ما لم يقله بوتين في خطابه صبيحة الغزو الروسي أن الشعب الأوكراني قد اختار وطناً أماً بعيداً عن روسيا وأن إرادته هي التي يجب احترامها أكثر بكثير من تصحيح الأخطاء التاريخية- هذا إذا صح أنها أخطاء.
اليوم ليس كقبله، وما سيليه سيكون تغييراً لوجه العالم، فإما أن تتوسع روسيا على حساب الغرب وشعوب أوربا الشرقية وأن تظهر إرادة “القيصر الجديد” فوق إرادات الشعوب والديمقراطيات الغربية، أو أنه سيتلقى ضربة قاصمة كما علمنا التاريخ قبل العصر النووي، لكن ونحن نقول بضرورة كبح جماح الطموح الإمبراطوري لبوتين فإننا ندرك صعوبة الرد العسكري من قبل الناتو، لا بل استحالته، بسبب المخاوف الحقيقة من اندلاع حرب عالمية ثالثة لن ينتصر فيها أحد.
تبين الأزمة الأوكرانية عمق الأزمة التي تسود العلاقات الدولية، ويمكن التعبير عن ذلك بأن العالم تقدم إلى درجة متميزة من العلاقات الإنسانية والتطور التقني والعلمي والقوانين الإنسانية وغيرها من دلائل تطور المجتمعات البشرية، لكنه تخلف في نقل المجتمعات البشرية كلها إلى درجات متقاربة على مقياس هذا التطور.
لا حاجة لنا إلى القول أن ما يحدث في أوكرانيا اليوم قد حصل ما يشبهه في سوريا، فدخول الجيش الروسي في نهاية أيلول/ سبتمبر 2015م قد حسم الوضع العسكري لصالح سلطة الطغمة، وبالتالي فإن أي هزيمة لروسيا في معركتها اليوم سيكون في صالح الحل السياسي في سوريا، لكن الواضح حتى الآن أن هذه الهزيمة “المأمولة” بعيدة المنال في ظل تراجع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين عن الدخول عسكرياً إلى جانب أوكرانيا التي لا تستطيع الصمود في وجه هذا الجيش الجرار.
وإذا كانت وصفة العقوبات قد أظهرت جدواها المحدودة مع دول مثل كوبا والعراق وكوريا الشمالية وإيران فهل ستكفي لإجبار إدارة بوتين على الانسحاب من أوكرانيا وأن يعيد حساباته في سوريا وغيرها من مناطق النفوذ التي يسعى لاعتقالها في سبيل تقوية أوراقه في مواجهة أوربا الغربية والنزوع الديمقراطي داخل المجتمع الروسي؟
لا شك بأن أي تحرك داخلي من الشارع الروسي سيكون له أثر كبير على مجريات الأمور، وإن كنا لا نتفاءل بحركة حقيقية داخل الشارع الروسي- لأسباب ليس هنا مكانها- لكن تباشير هذه الحركة بدأت من اليوم الأول للمعارك، وعلى أمل توسعها في حال طالت أمد الحرب وكانت تكاليفها باهظة، ومع أمنياتنا بأن تتوقف هذه الحرب العبثية وأن تكون تكاليفها في أدنى الحدود، فإننا نعتقد في تيار مواطنة-نواة وطن أن العمل على الضغط على إدارة بوتين بكل السبل وخاصة في الداخل الروسي سيعجل الانتهاء من هذه الأزمة وهذا الديكتاتور.
تيار مواطنة- نواة وطن
مكتب الإعلام 24 شباط/ فبراير 2022
—————————–

«مستنقع» روسي في أوكرانيا… دروس من الشيشان وأفغانستان/ كميل الطويل
هل تخاطر روسيا فعلاً، بغزوها الحالي لأوكرانيا، بـ«الغرق في مستنقع»، كما حصل في الماضي لجيشها في أفغانستان، في ثمانينات القرن الماضي، ولاحقاً في الشيشان، في تسعيناته؟ هذا ما لوح به مسؤولون غربيون في الأيام الماضية. ولكن هل هذا السيناريو واقعي فعلاً؟ هذه مقارنة سريعة بين دروس «مستنقعي» أفغانستان والشيشان وإمكان تكراره في أوكرانيا كما يأمل الغربيون اليوم:
– الشيشان… حربان بنهايتين مختلفتين
هدد مسؤولون غربيون، في أكثر من مناسبة، قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يخاطر بأن تتحول أوكرانيا إلى «شيشان ثانية» تغرق فيها القوات الروسية، في إشارة إلى أن الروس سيواجهون حرب عصابات وتمرداً على غرار ما حصل في هذه الجمهورية المسلمة في القوقاز في تسعينات القرن الماضي.
كان البريطانيون أوضح من لوح بهذا الخيار – المخاطرة، قبل أسابيع من بدء الغزو فجر أمس. في الأيام الماضية، أعاد البريطانيون التلويح بهذا الخيار مع «توضيح» أنهم كانوا يقصدون حرب الشيشان الأولى بين العامين 1994 و1996، وليس الثانية (1999 – 2000). جاء توضيحهم، على الأرجح، بعدما اكتشفوا أن التلويح بـ«شيشان ثانية» قد يعتبر بمثابة «دعوة» للرئيس بوتين للغزو، وليس لردعه عن الغزو. فحرب الشيشان الأولى، خلال عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن، كانت بالفعل «مستنقعاً» غرق به الروس وكلفهم خسائر فادحة (آلاف القتلى والجرحى)، وانتهت بهزيمتهم وانتصار المتمردين الشيشان. لكن حرب الشيشان الثانية التي أشرف عليها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، خلال توليه رئاسة الحكومة وبعد توليه الرئاسة، خلفاً ليلتسن، كانت في نظر الروس نصراً مبيناً. أنهت هذه الحرب التمرد في الشيشان وقضت عليه عملياً، رغم أنه جاء بثمن باهظ للشيشان الذين وجدوا عاصمتهم غروزني وقد تحولت إلى ركام نتيجة الضربات الروسية. وأعطى هذا الانتصار شعبية واضحة لبوتين الذي ظهر في أعين الروس ليس فقط بوصفه من أخضع المتمردين الشيشان بل أيضاً نتيجة قضائه على «تهديد إرهابي» كان يطرق أبوابهم في موسكو نفسها من خلال تفجيرات تستهدف أبنية سكنية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المتمردين الشيشان لم يحظوا، في حربيهم الأولى والثانية، بدعم غربي في مواجهة الروس، ربما نتيجة خوف العواصم الدولية الكبرى من وجود متشددين عرب يرتبط، بعضهم بتنظيم «القاعدة»، التحقوا بالشيشان بهدف تكرار تجربة «المستنقع الأفغاني» ضد الروس في القوقاز هذه المرة.
خسر المتمردون الشيشان الحرب ضد روسيا نتيجة عوامل عديدة، أحدها فقط غياب الدعم العسكري الغربي. الآن تختلف الصورة، كما يبدو، بالنسبة لأوكرانيا. فقد سارع الغربيون، وعلى رأسهم البريطانيون والأميركيون، إلى تزويد الأوكرانيين بـ«أسلحة دفاعية» بينها قاذفات صواريخ متطورة من طراز (جافلين) قادرة على توجيه ضربات دقيقة للمدرعات والدبابات الروسية. كما أن هناك جنوداً غربيين إلى جانب الجنود الأوكرانيين لتدريبهم على استخدام الأسلحة الحديثة التي تعطى لهم. لكن الغربيين أكدوا مراراً بأنهم لا ينوون الدخول في نزاع عسكري مباشر ضد الروس بسبب أوكرانيا، ما يوحي بأن هؤلاء الجنود – المدربين سينسحبون إذا ما تقدم الروس غرباً نحو كييف.
– أفغانستان… المستنقع الأول
عندما حذر الغربيون الروس من مستنقع شيشاني ربما كان في ذهنهم أفغانستان، لكنهم فضلوا عدم التلويح بهذا السيناريو لأنهم أنفسهم كانوا قد ذاقوا لتوهم مرارة الهزيمة في أفغانستان عندما اضطروا للانسحاب في أغسطس (آب) العام الماضي بعد غزو دام 20 سنة وانتهى بعودة حركة «طالبان» إلى سدة الحكم.
ولا شك أن بعض الغربيين يمني النفس الآن بأن أوكرانيا ستتحول إلى أفغانستان ثانية بالنسبة إلى الروس، كما كانت في الثمانينات ضد الجيش الأحمر. هنا، كان الغربيون أساسيين في تقديم الدعم للمجاهدين الأفغان. فقادة هؤلاء كانوا يستقبلون في عواصم العالم. يعقدون مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض مع الرئيس رونالد ريغان. لم يكن الدعم سياسياً فقط بالطبع. فقد أشرفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) على تزويد الأفغان بالأموال والأسلحة، بما في ذلك صواريخ «ستينغر» التي حرمت الجيش الأحمر من سيطرته المطلقة على الأجواء فوق أفغانستان.
لكن هناك فرقاً جوهرياً بين المثالين الأفغاني والأوكراني، حتى ولو وحد بينهما هدف الغربيين وهو إغراق السوفيات، من قبل، والروس، الآن، في «مستنقع» لا يستطيعون الخروج منه إلا مهزومين. والفرق هنا واضح. فالمجاهدون الأفغان كانوا ينطلقون من منطلق ديني إلى حد كبير. فقد حملوا السلاح في مواجهة «الشيوعيين الملحدين»، بنسختهم المحلية الممثلة بحكومة نجيب الله في كابل، أو بنسختهم السوفياتية ممثلة بـ«الجيش الأحمر». ولكن في مقابل حقيقة أن الأفغان، ومن بعدهم الشيشان، حملوا السلاح ضد السوفيات انطلاقاً من هدف ديني إلى حد كبير، فإن هذا العامل يكاد يكون غائباً كلياً في الحالة الأوكرانية في ضوء انتماء الأوكرانيين والروس ليس فقط إلى الديانة ذاتها بل أيضاً إلى العرقية السلافية ذاتها.
كما أن هناك فرقاً جوهرياً آخر بين الحالتين الأفغانية والأوكرانية. فالدعم الغربي للمجاهدين الأفغان ذهب إلى فصائل مسلحة كانت تقاوم حكومة «شرعية» قائمة في كابل. أما الدعم الغربي للأوكرانيين اليوم فهو يذهب إلى حكومة قائمة فعلاً في كييف وإلى جيشها النظامي، وليس إلى مجموعات مسلحة، كما كان الحال في أفغانستان. لكن بالطبع هذا السيناريو يمكن أن يتغير لاحقاً إذا ما تمكن الروس من إطاحة حكومة الرئيس فولودومير زيلنسكي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى قيام مجموعات مسلحة تقاوم الروس. وثمة مؤشرات بالطبع إلى احتمال حصول هذا الأمر في ضوء توزيع حكومة كييف السلاح على المواطنين الراغبين في «مقاومة الغزاة».
—————————–
العالم العربي ليس معزولاً… الرابحون والخاسرون من الغزو الروسي لأوكرانيا/ أحمد ياسر
من المرجح أن الحرب الروسية على أوكرانيا لن تقتصر مضاعفاتها على أوروبا وحدها فحسب، بل ستكون لها مضاعفات كبيرة على البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سيرسل الغزو الروسي لأوكرانيا موجاتٍ صادمةً إلى الدول العربية التي تستورد القمح والأسلحة من موسكو وكييف، وحتى الدول التي توجد فيها قواعد روسية، إذ قد تجد نفسها ضحيةً للصراع إذا تصاعد نحو مواجهة أكبر مع الغرب. في المقابل، قد تستفيد دول الخليج العربي من ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيحمل لها مكاسب ماليةً ضخمةً، فضلاً عن أنه من المتوقع أن تأخذ حصة روسيا في السوق الغربي، ما سيُمكّنها على الأرجح من استعادة صورتها وأهميتها لدى الغرب.
توظيف عسكري
تُعدّ ليبيا وسوريا اللتان مزقتهما الحرب، من بين الدول الأولى التي ستتأثر بشكل مباشر بنزاع عسكري مفتوح بين روسيا وأوكرانيا، وتمتلك موسكو قاعدتين عسكريتين فيهما. وقال سامي حمدي، العضو المنتدب لشركة إنترناشيونال إنترست، وهي شركة عالمية للمخاطر والاستخبارات في لندن، للإذاعة الألمانية: “تحتفظ روسيا بقاعدة الجفرة الجوية التي يمكن استخدامها على الفور في حالة نشوب حرب مع أوكرانيا”.
وأضاف حمدي: “قد نرى فجأةً استعداداً دولياً جديداً للتعامل مع القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر، الذي كان يشعر بالبرودة في ما يتعلق بواشنطن والقوى الأوروبية الأخرى في الماضي”.
وأشارت المحللة السياسية الإيطالية سينزيا بيانكو، للإذاعة الألمانية إلى احتمال أن تحاول موسكو الضغط على أوروبا من خلال موجة جديدة من اللاجئين القادمين من ليبيا، على غرار ما جرى على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا.
تمتلك روسيا أيضاً ميناءً بحرياً وقاعدةً جويةً في مدينة طرطوس في سوريا، حيث يوجد الحليف المقرب إليها، وهو الرئيس السوري بشار الأسد الذي اعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
في سوريا، وضعت روسيا وإسرائيل اتفاقاً سمح لتل أبيب بشن ضربات على الأصول الإيرانية. وقال حمدي إن “إسرائيل قد تصبح الخاسر الأكبر في أي حرب بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك لأنها ستضطر إلى الانحياز إلى أي طرف بطريقة تقوّض أي مكاسب حققتها في سوريا”.
صفقات السلاح
واقترح المشرّعون الأمريكيون أنه يمكن إزالة روسيا من نظام SWIFT، وهي شبكة تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم. هذه الخطوة ستحرم روسيا من التعامل بالدولار مع دول العالم، وعليه فإن عدداً من الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات، سواء لشراء أسلحة أو قطع غيار لأسلحتها الروسية، أو بناء محطات نووية مثل محطة الضبعة في مصر، أو تصدّر سلعاً إلى موسكو، قد تتعطل وتنكمش، وكذلك توافد السياح.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي والأكاديمي في جامعة جورج واشنطن، عاطف عبد الجواد، لرصيف22، إن “الدول العربية، لن تكون قادرةً على إتمام صفقاتها مع روسيا، خاصةً العسكرية، لأنها تعتمد في دفع واستلام أي أموال على شبكة تحويلات سويفت الغربية”.
وأضاف: “سيكون من الصعب العثور على وسيلة أخرى إلا في حالات نادرة تعتمد فيها روسيا على احتياطي ضخم من العملات الصعبة جمعته خصيصاً لتجاوز المقاطعة المالية وقيمة هذا الاحتياطي نحو 80 مليار دولار سوف ينضب بسرعة مع مرور الوقت”.
القمح والعواقب
تصدّر أوكرانيا وروسيا 23% من صادرات القمح العالمية، وتقترب أسعار المواد الغذائية العالمية بالفعل من أعلى مستوياتها في عشر سنوات، وتعني حصة البلدين في السوق أن أي اضطراب في الصادرات قد يتسبب في ارتفاع أسعار الحبوب.
وأفاد تقرير نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن بأن “أوكرانيا تصدّر 95% من حبوبها عبر البحر الأسود، وذهبت أكثر من 50% من صادراتها من القمح إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020″، وعليه فإن أي اضطراب ستكون له “عواقب وخيمة” على الأمن الغذائي في هذه البلدان.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان وليبيا يستوردان نحو 40% من قمحهما من روسيا وأوكرانيا، واليمن نحو 20%، ومصر نحو 80%.
ورأى جوليان بارنزداسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، أن التأثير على الشرق الأوسط قد يكون أسوأ بكثير من دول أخرى. وقال لشبكة سي إن إن الأمريكية: “من الواضح أن المخاوف من الصراع بين اثنين من كبار الموردين في العالم سيكون لها بعض التأثير على الأسعار، في حين أن هناك بالفعل شعوراً بالنقص”.
وقالت الشبكة الأمريكية إن هذا النقص على المدى الطويل قد يؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل في بعض بلدان المنطقة. ويعاني ما يقرب من 69 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نقص التغذية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، وهو ما يمثل نحو 9% من النقص الإجمالي العالمي، ويوجد الكثير منها في بلدان مزقتها النزاعات.
أشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن الجوع آخذ في الارتفاع منذ عام 2014 في المنطقة
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن الجوع آخذ في الارتفاع منذ عام 2014 في المنطقة، في ظل تدهور سبل العيش بعد انتفاضات الربيع العربي، ومرةً أخرى بعد جائحة كورونا. وقدّرت المنظمة معدّل انتشار نقص التغذية في المنطقة في عام 2020 بنسبة 15.8%، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 9.9%.
وقال محللون لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الدول والجهات المانحة قد تكون قادرةً على شراء الحبوب من مصادر أخرى، لكن ارتفاع الأسعار قد يعيق شبكةً من المستوردين تعاني بالفعل من نقص في التمويل.
من جانبه، قال المستشار السابق لوزارة الإمدادات المصرية، نادر نور الدين، للشبكة الأمريكية: “قد يكون هذا درساً جديداً (للدول العربية)، مفاده أنه يجب علينا موازنة المشتريات، حتى نتمكن دائماً من تنويع الإمدادات وتأمينها بشكل دائم إذا كانت هناك صراعات”.
مكاسب مالية وتحسين صورة
وفي سياق متصل، قال عاطف عبد الجواد، إن “أسعار النفط تخطّت المئة دولار للبرميل، وفي هذا فائدة لدول الخليج وخاصةً قطر أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن المنفعة التي تعود على دول الخليج جراء الأزمة الروسية الأوكرانية تأتي للدول الخليجية أيضاً بمعضلة، ويتطلب الأمر توازناً دقيقاً من جانبها في إدارة علاقاتها بين روسيا والغرب”.
وأضاف عبد الجواد: “دول الخليج دخلت في الآونة الأخيرة في علاقات أقوى مع روسيا، وبعضها قررت عقد صفقات أسلحة روسية. كيف تستفيد هذه الدول مالياً من دون إغضاب موسكو؟ تلك مسألة تحتاج إلى مهارة في إدارة العلاقات مع روسيا. وبالمثل كيف ترضي هذه الدول روسيا من دون إغضاب الغرب؟ تلك مسألة شديدة الحساسية وخاصةً أن دول الخليج ما زالت تعتمد على الغرب في حماية أمنها”.
ووفقاً لتقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن، فإنه يمكن لقطر توفير المزيد من الغاز لأوروبا، في ظل خطتها لتوسيع قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي، ما يساعد الدوحة على تحسين صورتها وفرصها في توقيع عقود طويلة الأجل مع مشترين أوروبيين. وزادت مصر أيضاً من إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ويمكن أن توفر الجزائر سبعة مليارات متر مكعب إضافية سنوياً إلى الاتحاد الأوروبي.
ويمكن لمنتجي النفط أيضاً كالمملكة العربية السعودية والعراق والكويت، والتي تمتلك منتجاتٍ نفطيةً مماثلةً لروسيا، تزويد أوروبا بالنفط الذي توفره روسيا. في عام 2021، كانت صادرات تلك الدول الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي أقل بثلاث مرات من صادرات روسيا.
وذكر التقرير الأمريكي أن هذه الخطوة يمكن أن تؤكد سمعة هذه الدول، كمنتجين موثوق بهم، ويمكن أن تؤمن عقوداً طويلة الأجل في سوق النفط الأوروبية على حساب حصة روسيا فيه، والتي من شأنها أن تنخفض إذا تعرضت البنوك والشركات الروسية للعقوبات.
من جانبه، قال الصحافي السعودي عادل الحميدان، إن أسعار النفط ارتفعت حتى قبل اندلاع الأزمة، وهي بالفعل تحقق مكاسب أكبر الآن لكن من غير الوارد أن تنحاز دول الخليج إلى الغرب ضد روسيا.
وأشار الحميدان إلى أن دول الخليج مرت بأزمة ثقة مع الولايات المتحدة، خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما، وهذا ما يدفعها إلى عدم الانحياز ضد روسيا، لكنها ستعمل على حفظ التوازن في الأسعار احتراماً لالتزاماتها الدولية.
ورجح عاطف احتمالية انهيار “أوبك بلاس”، وهي الدول المنتجة للنفط من خارج منظمة أوبك وتقودها روسيا، إذا استمر عزل موسكو عن منظومة سويفت للتحويلات المالية، مؤكداً أن OPEC Plus لن تصمد أمام تدهور الصادرات الروسية حتى لو عوّضت الصين خسائر روسيا، ولن يقع اللوم على السعودية أو أوبك في انهيارها.
————————–
مستقبل “النانو بولتيك” الروسي في سوريا/ إبراهيم الجبين
الشيخ طريف قطع بالرسالة التي حملها إلى موسكو الطريق على العمليات الروسية في السويداء فما يمكن تطبيقه في درعا وحمص وحماة غير ممكن في معقل الطائفة الدرزية السورية.
تستطيع البوتينية اليوم إظهار قدراتها الهائلة في مواجهة ما تسميه بالخطر الداهم والتهديد الوجودي أمام اقتراب قوات الناتو من حدودها، كما يجري في الأزمة الأوكرانية المتصاعدة، إلا أنها تصعّب الأمر كثيرا في الملف السوري. فهي موجودة وفق صفقة مع القطب الذي تقاومه في الشمال من سوريا، حيث أوكرانيا. وصفقتها تلك التي توافق عليها وزيرا الخارجية سيرجي لافروف وجون كيري في جنيف ما تزال تعمل إنما من دون تحديد مشهد ختامي.
تبدو روسيا كمن يقوم بعمليات جراحية دقيقة في جسد النظام السوري، كما فعلت وتفعل عسكريا مع الفصائل الخارجة عن سلطته. عمليات يمكن تسميتها بـ”النانو بولتيك” في مفاصل الدولة ومؤسساتها لإحداث التغيير المتفق عليه، ولكن هل يشعر بوتين أنه متاح له الاطلاع الكافي على كامل المشروع الأميركي في سوريا؟ الأمر ليس مؤكدا حتى الآن، بدليل محاولته سحب ورقة حزب العمال الكردستاني من أيدي الأميركيين، كما عبّرت عن ذلك تصريحات مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الأخيرة والتي طالب فيها بضم ما تعرف باسم “مسد” إلى اللجنة الدستورية والعملية التفاوضية.
بعض المسؤولين الروس مستعجلون، لم يعودوا قادرين على تحمّل سياسة الصبر الاستراتيجي التي يتمتع بها بوتين، والتي يحرص عليها رئيس النظام السوري بشار الأسد كل الحرص، آملا بالاستفادة من المتغيرات من حوله. تلك السياسة التي برهنت على جدواها مرارا بالنسبة إليه.
غير أن روسيا لن تتبع في سوريا نهجا مخالفا لما اتبعته في جمهورياتها ذاتها، وفي روسيا الأم حيال الدعوات إلى التظاهر ومحاولات تعزيز وجود معارضة سياسية حقيقية تمارس ضغوطا على القرار المركزي في الكرملين. وهذا ما فعلته في السويداء مؤخرا، حين سرّبت أجهزتها أنباء عن هجمات إرهابية قد تحدث في حال تنامي الحراك الشعبي المطلبي في جبل العرب. هو “نانو بولتيك” أيضا، يجري بالتنسيق مع طرف آخر هذه المرة، فروسيا التي تخشى على هيمنة مؤسسات النظام في منطقة حساسة، ليست صاحبة القرار الوحيد في تلك المنطقة، وهو ما عبّرت عنه زيارة خاطفة قام بها شيخ عقل الموحدين الدروز في فلسطين موفق طريف، والذي يمثل ثقلا من نوع آخر لم يكن قد دخل على خط الأزمات في سوريا من قبل.
بعض المسؤولين الروس مستعجلون، لم يعودوا قادرين على تحمّل سياسة الصبر الاستراتيجي التي يتمتع بها بوتين، والتي يحرص عليها رئيس النظام السوري بشار الأسد كل الحرص
قطع الشيخ طريف بالرسالة التي حملها إلى موسكو الطريق على العمليات الروسية في السويداء، فما يمكن تطبيقه في درعا وحمص وحماة وريف دمشق، غير ممكن في معقل الطائفة الدرزية السورية.
انزعج الروس مما أبلغهم به الشيخ طريف، فهو لم يكتف بالحديث عن تحسين الظروف المعيشية للسكان في السويداء، ولم يقض الوقت في هذا الفصل البارد من السنة في موسكو بالحديث عن التسوية مع بوغدانوف رفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف.
بدت جميع مطالب الشيخ طريف مقبولة تماما من جانب الروس، مثل ضرورة إيجاد آلية لتقديم المساعدات لأبناء الطائفة في الجبل، وتسهيل إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية لتنمية الاقتصاد المجتمعي، علاوة على فتح معبر آمن مع الأردن لإنعاش جبل العرب اقتصاديا وتوفير فرص المعيشة اللائقة، وضرورة ترسيخ مكانة وموقع الدروز في الدستور السوري الذي تجري مناقشته تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي الواقع أن الدروز السوريين لم يكترثوا مرة واحدة في تاريخهم الوطني الطويل في سوريا بمسألة مكانتهم في الدستور، ولم يقلقوا من أي تهميش أو استثناء، فقد كانت حقوقهم تلك خارج أي نقاش، حفروها بأيديهم من خلال دورهم الوطني السياسي الكبير في كل مرحلة مرّت بها البلاد.
لكن كانت كلمة السر في تلك الاجتماعات أن هناك من يراقب الأوضاع وأن خطا أحمر حقيقيا هذه المرة يتعلق بتهديد وجودي يطال الموحدين الدروز يكاد الأسد وداعموه الروس يدوسون عليه وأن إسرائيل لن تسمح بذلك.
هذا المتغيّر الجديد يخالف الاتفاق القائم بإطلاق اليد الروسية في هندسة الأوضاع السورية، فحتى العامل الإيراني استطاعت روسيا التغلب على تناقضاته داخل الساحة السورية، وإمساك العصا من المنتصف دون أن يعرقل هذا العمليات العسكرية الإسرائيلية والأميركية هناك.
تحوّل يكبّل يد الروس أكثر من يد الأسد، فماذا لو أفلتت الأمور في السويداء؟ وتحولت إلى مكان خارج سيطرة الأسد، لكن هذه المرة، لا توجد حركات إسلامية سنية متطرفة ولا قاعدة ولا داعش ولا ما يشابهها. كيف ستكون الحال آنئذ؟
الجواب عند الروس لم يكن في السويداء، ولكن في اللعب على وتر ما تعرف باسم الإدارة الذاتية الكردية، وما دام هناك من يطالبهم بتخفيف القبضة عن مكون سوري في الجنوب، فلماذا لا تكون لهم حصة عند مكون آخر في الشمال؟ بمعنى آخر، لماذا تثقون بنا في السويداء ولا تثقون بنا في التعامل مع الأكراد؟
ستبقى سوريا لغزا حتى بالنسبة إلى الروس، وليس مضمونا أن تنجح عملياتهم الدقيقة مادامت الصلاحية الحيوية لكافة المشاريع السياسية القائمة والمقترحة في سوريا قد انتهت، فهم يقومون بكل ما يمكنهم القيام به، دون أن تتقدم الأمور. لا يمكن إعادة الساعة إلى الوراء وإحداث نصر سياسي كما حصل عسكريا، والعقوبات تزيد الأوضاع سوءا، ومحاولة رفعها ليست مضمونة إلا بالخروج عن قرارات مجلس الأمن التي تعتبر العمود الفقري للعملية التفاوضية والحل السياسي الذي يقول العالم إنه الوحيد في سوريا. وحتى يحصل ذلك يمكن للروس أن يستخدموا الورقة السورية للقول إنهم موجودون أيضا على حدود الناتو الجنوبية ومسيطرون تماما انطلاقا من سوريا التي زارها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويوغو فجأة في عز الحديث عن غزو أوكرانيا، تزامنا مع إعلان روسيا وصول قاذفات محملة بصواريخ فرط صوتية من نوع كينجال إلى قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا، للمشاركة في التمرين البحري للتجمع المشترك بين أساطيل البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط.
كاتب سوري
العرب
———————–

======================
تحديث 26 شباط 2022
—————————
معضلة بوتين/ محمد ديبو
على خلفية تصاعد الصدام بين الغرب وروسيا، وبعد دخول روسيا إلى أوكرانيا في احتلال عسكري يذكّر بأزمنة الاستعمار ومناخات بداية الحرب العالمية الثانية، تتحدث أصواتٌ كثيرة عن مشروعية التحرّكات الروسية أو أحقيتها لمواجهة تقدّم حلف الناتو ودول أوروبا باتجاه حدودها أو تهديد أمنها القومي، مضافة إليه تبريرات كثيرة تتعلّق بعدم احترام الغرب تعهداتٍ قطعها لموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بعدم ضمّ الدول المستقلة إلى منظومته الأمنية والعسكرية، بل ذهبت تحليلاتٌ أبعد من ذلك، حين رأت أن حلف الناتو كله لم يعُد له مبرّر، وبالتالي، فإن السلام العالمي يتطلّب حل هذا الحلف.
قد تكون الحجج أو الذرائع السابقة محقّة وقد تكون لا، وعلى افتراض صحتها، نكون أمام سؤال: هل حقا تُحل مسألة روسيا والرئيس بوتين لو احترم الغرب تعهداته وابتعد عن الحدود الروسية؟ وهل المسألة هنا أساسا أم في مكان آخر؟ تتعامى أغلب هذه التحليلات عن جوهر المشكلة، إن المشكلة القائمة اليوم في روسيا، وهي مشكلة عالمية بامتياز أيضا، تتجلى في المعاندة الروسية لروح العصر المتمثلة بالديمقراطية، وفي قيادتها إلى جانب الصين المعسكر المعاند للثورات والتغيير، وذلك تحت شعارات شتى، لا تذكّرنا إلا بشعارات الأنظمة العربية، التي شنقتنا باسم تحرير فلسطين والقومية العربية والأمن العربي وغيرها من مفردات يستمدّها فلاديمير بوتين اليوم من أرشيف الحرب الباردة، ومن مفردات المعجم السوفياتي العقيم، محاولا بث الروح فيها لشدّ وشحذ الهمم.
مشكلة بوتين الأساسية لا تكمن في أنّ الغرب قد أخلّ بتعهداته تجاه موسكو، أو في عدم أخذه المصالح الروسية بالاعتبار، فهذا طالما كان جزءا أساسيا من عالم السياسة وصراعاتها، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها. وعليه، ومن هذا الباب، يحقّ لبوتين الدفاع عن مصالح روسيا بوجه خصومها، ولا شك في هذا. المشكلة الأساس ليست هنا، بل في كيفية خوضه تلك المعركة، ومن أي موقع.
يخوض بوتين معركته ضد الغرب الديمقراطي من موقعه دكتاتورا يسعى إلى تثبيت أركان حكمه، بل هو لا يتورّع عن الإعلان عن إفلاس الديمقراطية الليبرالية، ساعيا إلى فرض نظام بديل عنها، هو النظام الدكتاتوري الفردي الأمني الذي أقامه في بلاده، والذي لا يتورّع عن تغيير الدساتير والقوانين بما يتلاءم مع شخصه في البقاء إلى الأبد في سدّة الرئاسة، بما يعني أن بوتين لا يتورّع عن توظيف كل شيء في خدمة هذه المعركة التي لها الأولوية على أيّة معركة أخرى، وكأنّ كل الدروس المستفادة من هزيمة التوتاليتارية السوفياتية، وفي كل أنحاء العالم، ومن الأثمان التي نراها أمام أعيننا من هيمنة السلطويات العربية، قد ذهبت هباءً، حيث علمتنا التجارب أنّه لا يمكن لشعب مقموع مواجهة “المؤامرات المحاكة” ضد بلاده، وأن “الطغاة يجلبون الغزاة” وليس العكس أبدا، لأن الاستبداد لا يفعل إلا تجفيف منابع المقاومة في الداخل، وتحويل الشعوب إلى أدوات لمشروع الدكتاتور الذي تتعاظم حاجته يوما بعد يوم إلى معارك خارجية وبهلوانيات سياسية لتحفيز الشعور القومي وشحذ الهمم خلف قيادته. أليس هذا ما تقوم به بهلوانيات بوتين التي يطلّ بها علينا بين فينة وأخرى؟
قد ينتصر بوتين في معركته في أوكرانيا وقد يخسر، وقد يهين رؤساء آخرين، كما أهان مرؤوسيه وفعل مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقبله الدكتاتور السوري بشار الأسد في أكثر من مناسبة، ولكن هذا كله وغيره لا يغيّر من حقيقة أن بوتين دكتاتورٌ يسعى إلى إقامة إمبراطورية دكتاتورية تحت اسم استعادة المجد السوفياتي أو القيصري، أو استعادة كرامة روسيا الدولية، ولو كان هذا على حساب الشعب الروسي والشعوب المجاورة، ففي مثل هذا العقل، لا تغدو الشعوب أكثر من بيادق لتحقيق الطموحات القومية التي تتخفّى في ظلها إرادة الدكتاتور للقبض على الحكم. هذه هي المسألة، وسواء انسحب بوتين من أوكرانيا لاحقا أم لا، وسواء تراجع الغرب أمام المطالب الروسية أم لا، فإن بوتين مهزومٌ في نهاية المطاف وعلى المدى الطويل، لأن التاريخ، علمنا، وبالتحديد التاريخ السوفياتي، أن من يصادر حرية شعبه لا ينتصر أبدا، ولو غزا العالم بأسره، أو ليس هذا ما فعله، حين اعتقل المعترضين على حربه على شعبٍ كان مائة عام، وربما أكثر، شعبا واحدا مع شعبه!
وإن كان من خطيئة ما ارتكبها الغرب في هذا السياق، فهي في تغليبه البعد الأمني على مسألة الديمقراطية التي تتراجع في كل أنحاء العالم اليوم، نتيجة خدلان السياسات الغربية وتواطئها (ولهذا حديث طويل)، وهي تحصد ثمن هذا في أوكرانيا اليوم.
العربي الجديد
—————————
روسيا وأوكرانيا: تقاطعات عربية وإقليمية!
عبّرت بعض السلطات العربية عن تأييد واضح للاجتياح الروسيّ لأوكرانيا، كما حصل من قبل السودان، الذي لم تكتف سلطاته بإعلان وقوفها مع موسكو، بل ابتعثت أيضا نائب رئيس «المجلس السيادي» محمد حمدان دقلو، الذي سافر إلى العاصمة الروسيّة خلال فترة الغزو لتأكيد ذلك التأييد.
أعلنت الإمارات بدورها تأييدها لموسكو عبر الحديث عن «الشراكة الاستراتيجية» التي تجمع البلدين، في اتصال لوزير خارجيتها عبد الله بن زايد بنظيره سيرغي لافروف.
لا ضرورة للتأكيد على موقف النظام السوري حيث أظهر رئيسه، بشار الأسد، ابتهاجه بالاجتياح و«اعترافه» بالجمهوريات الانفصالية، وكان وزير خارجيته فيصل المقداد في موسكو أيضا. دمشق، في عرف السياسة الخارجية الروسية، هي نظير الشيشان، الذي عيّن فيه بوتين رئيسه رمضان قديروف، وبيلاروس، التي انطلق جزء من الهجوم من أراضيها، و«الجمهوريات» الانفصالية التابعة للكرملين في جورجيا ومولدوفيا وأوكرانيا، والدول المحسوبة عليها، كأوزبكستان، التي أعلنت تأييدها للعملية بالطبع، والحليفة لها، كالصين، وإيران، التي برّرت الاجتياح بـ«استفزازات الناتو».
اختارت الدول العربية الأخرى التزام موقف وسطيّ، كما فعلت مصر التي أكدت على «أهمية تغليب لغة الحوار» والأردن الذي طالب بـ«بذل أقصى الجهود لضبط النفس» فيما أجرى وزير الخارجية القطري اتصالين بنظيريه الأوكراني والروسي، ودعت الكويت «لتسوية النزاع بالطرق السلمية». إدانة الهجوم الروسي جاءت من قبل الحكومة الليبية في طرابلس، وكذلك من قبل الخارجية اللبنانية، فتعرضت لانتقادات أطراف مؤيدة لـ«محور الممانعة» وكان موقف تركيا مميزا بدوره، حيث رفض الاجتياح الروسي، وانتقد رئيسها، رجب طيب اردوغان، موقف «الناتو» غير الحاسم.
امتنعت السلطة الفلسطينية عن التعليق على الهجوم الروسي، ولم يظهر سوى تعليق مؤيد للاجتياح من قبل «الجبهة الديمقراطية» يندد بـ«الإجراءات العدوانية» لأمريكا وأوروبا ضد روسيا. حسابات السلطة الفلسطينية، في الموضوع، تتعلّق بالحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو، التي هي جزء من «اللجنة الرباعية الدولية للسلام» من دون إغضاب الغرب، الذي يؤمن أشكالا من التمويل للسلطة، وآليات دولية وشعبية لمناهضة إسرائيل. يكمن وراء هذا الموقف، أيضا، رأي عام فلسطيني ينظر إلى العالم بمنظار يعتبر ما يضرّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، ويفيد خصومها في روسيا والصين وإيران، مفيدا للقضية الفلسطينية.
تتعلق مواقف الدول العربية من الأحداث العالمية (بما فيها حدث خطير مثل اجتياح أوكرانيا) بحسابات سياسية مباشرة، لكن جذرها الحقيقي يكمن في تقديس منطق القوّة، الذي يحكم العلاقات بين الأنظمة وشعوبها، وبين الأنظمة والقوى الدولية، وهو ما يفسّر، على سبيل المثال، علاقة بعض الأنظمة الوثيقة بإسرائيل وروسيا معا، أو بعلاقة التبعية المطلقة لموسكو (مع جعجعة فارغة ضد إسرائيل) كما هو حال نظام الأسد.
رغم أن الحدث الأوكراني لا يهدد النظم العربية بشكل مباشر فإن تداعياته الجغرافية ـ السياسية ستكون مؤثرة، كما أن تداعياته الاقتصادية ستكون واضحة، من حيث الأثر الكبير على أسواق النفط والغاز والقمح والذرة، حيث تعتمد عدة بلدان عربية على القمح الأوكراني، وستنعكس العقوبات على روسيا على أسعار النفط والغاز، وهو ما سيضغط على اقتصادات بلدان عربية عديدة، وستضيف أسعار الطاقة والغذاء والطيران والنقل أعباء اقتصادية على عشرات الملايين من سكان المنطقة.
يبقى القول إن الحسابات السياسية الضيّقة، وزيادة الاستقطاب بين أنظمة قوية وشعوب ضعيفة، والابتعاد عن المبادئ التي تؤكد على سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مسائل هي في صلب نضال الشعوب العربية، والموقف من الاجتياح الروسي، هو أيضا، موقف من الاحتلال الإسرائيلي وطغيان الدكتاتوريات، وأن قبول احتلال في مكان بعيد عنا، هو قبول لاحتلال آخر يجثم فوق صدورنا.
القدس العربي
—————————-

عن يسار عربي يحيا في زمن الحرب الباردة/ أحمد شوقي أحمد
ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على اهتمامات الكثير من نشطاء وقادة اليسار العربي، إذ ما يزال البعض يعتقد أن روسيا هي الوريث والامتداد الطبيعي للاتحاد السوفييتي المنحل، ويؤيد الحرب الروسية المجحفة بحق أوكرانيا، ومع التأكيد على أن حقيقة أن الأمن القومي لروسيا في خطر، فإن الحقيقة الثانية هي أن مصير أوكرانيا والعالم كله أصبح في خطر، في ظل الخطوات الروسية الأخيرة.
كره اليسار العربي للولايات المتحدة والغرب له ما يبرره، الماضي الاستعماري لتلك الدول، التدخل في شؤون الدول العربية والدول النامية في العالم، السياسات القذرة والخبيثة التي عملت على إحباط الازدهار والتقدم والانتقال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نحو العصر الحديث، والدعم الكبير لدولة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، لكن مما لا شك فيه، أن هناك أسبابًا ذاتية، تتعلق بالتخلف الثقافي والاجتماعي الذي تعيشه تلك المجتمعات، والتي لم تتمكن من مواكبة التطورات المادية التي شهدها العالم، كما أن الأهم، أن روسيا والصين، ليستا النقيض الموضوعي والإيجابي لأمريكا والغرب.
إن عدم ممارسة اليسار العربي للنقد الذاتي قد أفقدته توازنه، بل والضرورة الموضوعية لوجوده أصلًا، ناهيك عن أن التطبيق السوفييتي للنظرية الماركسية، سبب لها، ولحركات اليسار المتأثرة بالنهج السوفييتي، العار، فأبسط مراجعة لتاريخ الاتحاد السوفيتي، تشير إلى مدى كارثية العديد من الأفكار والمبادئ التي تم تطبيقها في دول المعسكر الشيوعي، وعن الهدر الذي لحق بالإنسان والإنسانية جراء السلطوية المتوحشة للأنظمة الشيوعية، والرؤية الشمولية بل والفاشية تجاه كل ما هو مختلف.
إضافةً لما سبق، فقد استحكمت صراعات وتناقضات الحرب الباردة بين دول المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، في تعبئة وتلقيم العقل اليساري العربي، بمنظومة هجاءات أيديولوجية، وشعارات دوغمائية، معززة بالدعم المادي واللوجستي الذي كان يقدمه الاتحاد السوفييتي لحلفائه من حركات وأنظمة، في قولبة تلك الحركات والقيادات والأطر، وفي اتكاليتها النظرية المفرطة على توجهات وسياسات وصراعات وأفكار السوفييت، والتي أثبتت فشلها الذريع في الواقع العملي، الفشل الذي تكلل بالانهيار الدراماتيكي للاتحاد السوفييتي وتفككه.
وحتى نصل إلى مقاربة واضحة وصادقة، فكريًا وسياسيًا وأخلاقيًا للأزمة الأوكرانية، فلا بد من الإشارة إلى أن أوكرانيا قد دفعت ثمنًا باهضًا إبان الحكم السوفييتي لغطرسة موسكو، هذا الثمن، تمثل في موت الملايين من الأوكران بسبب السياسات التعسفية اللينينية والتروتيسكية والستالينية تجاههم، فمن تأميم الأراضي الزراعية في أوكرانيا، وتحويل الملّاك إلى فلاحين يعملون بالسخرة، إلى مصادرة المحاصيل لصالح الجيش الأحمر في الحرب الأهلية الروسية، إلى التأميم الثاني والشامل في عهد ستالين للأراضي الزراعية، وبيع المحاصيل والحبوب خصوصًا لدول العالم، في الوقت الذي عانى فيه المزارعون من المجاعات، للمرة الثانية، إلى معسكرات الاعتقال الجولاج، والمجازر التي مورست بحق الآلاف من الأوكرانيين بحجة التعاون مع النازية… إلخ من الممارسات الوحشية الفاشية للنظام الشيوعي آنذاك.
وفوق كل ذلك، فقد أجبرت أوكرانيا للاحتفاظ باستقلالها إبان انهيار الاتحاد السوفييتي ما بين عامي 1989 – 1991، إلى التخلي عن الترسانة النووية التي كانت تملكها، والتي كانت تمثل ثلث الترسانة النووية للاتحاد السوفييتي، وذلك لأن روسيا، التي اعتبرت نفسها الوريث والوصي على إرث الاتحاد السوفييتي، قد تمسكت بمطالبتها بتلك الترسانة النووية، هذه المطالبة التي وجدت تواطؤًا من الغرب، بحجة الخوف من أن تكون أوكرانيا إحدى الدول النووية الكبرى بما لديها من مخزون هائل من الرؤوس النووية، تلك التنازلات قدمها أوكرانيا في مقابل ضمانات أميركية بريطانية أوروبية روسية، بضمان استقلالها والحفاظ على أمنها.
اليوم يتشكل حلف الناتو من 30 دولة، بينها العديد من الدول التي كانت منضوية ضمن المعسكر الشيوعي، بما فيها بولندا التي كانت تحتضن حلف وارسو الذي يضم دول المعسكر السوفييتي، إضافةً إلى المجر وبلغاريا ورومانيا وجمهوريات صربيا السابقة كالجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو، ناهيك عن استونيا وليتوانيا ومقدونيا… إلخ، وكل هذه الدول، باستثناء صربيا، كانت ضمن يوغسلافيا، ألم يسال اليساريون العرب أنفسهم، لماذا هرعت تلك الدول للانضمام إلى الحلف العسكري الرأسمالي الأكبر؟! لماذا تخلت عن ماضيها الشيوعي وأحلامها الأممية بتلك السهولة والسرعة؟ وأعتقد أن الجواب واضح: الهروب من القمع والفاشية السوفييتية، وورثتها الجدد.
وللإجابة عن السؤال الذي افتتحنا به هذا المقال، فروسيا بوتين، ليست ولن تكون في أي وقت روسيا الاتحاد السوفييتي، والصين “الشي جين بينجية” لا ولن تكون الصين الماوية الشيوعية، وإذا كانت المصالح الأيديولوجية والطموحات الإمبراطورية لتلك الدول، وفي ظل الصراع مع المعسكر الرأسمالي الغربي، قد دفعتها في يوم ما لتقدم بعضًا من الدعم المادي أو اللوجستي لبعض الدول النامية، بهدف استمالتها، فهذا لن يحصل مجددًا، إن الصين وروسيا أصبحت نماذج أكثر رداءة للنموذج الرأسمالي الغربي في الاستغلال والطموح الجامح للسيطرة، أما تجليات هذه الرداءة والتشوه، فيمكن ببساطة في كونها دول دكتاتورية قمعية تقوم على فكرة الهيمنة مع جشع وعقد عميقة مدفوعة بهدف الاستغلال وفرض الهيمنة.
وإضافةً لكل ما سبق، فإن التطورات الخطيرة، التي أفضت إليها مواقف الرئيس بوتين، ستنعكس بصورة أكثر خطورة في مآلاتها، خصوصًا إذا ما استطاع بوتين فرض هيمنته وتحقيق أهدافه في أوكرانيا، وعجز الغرب عن كبح جماحه ولجمه، فقد أصبح من البديهي إذا ما حدث ذلك أن تسعى الصين لتكرار التجربة البوتينية، من خلال فرض هيمنتها، عن طريق الحرب على تايوان، وهو ما يرفع احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة إلى مستوى شبه المؤكد، وحينها لا نعرف إن كان العالم سيبقى إلى ما بعدها أم سيفنى، أما في أقل الاحتمالات الممكنة، فإن الحرب الجارية في أوكرانيا تهدد بلداننا العربية بالجوع، خصوصًا مع احتمال توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا إلى بلداننا، وبالتالي انتظار المجاعات المُهلكة، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الخطيرة التي قد تحيق بالمنطقة العربية كلها جراء هذه الحرب.. فهل يعي اليساريون العرب المهللون لروسيا هذه الاحتمالات الكارثية؟ أشك في ذلك!
الترا صوت
——————————–
بوتين “أستاذاً” للتاريخ/ بيار عقيقي
لم يكن خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الإثنين الماضي، الذي أعلن في ختامه اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، عادياً في العصر الحالي. تحدّث الرجل كما لم يفعل سابقاً، حتى أن خطاب إعلانه ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 لم يتضمّن تفاصيل “تاريخية”، مثلما فعل مع أوكرانيا أخيراً. لخّص بوتين، في كلمته، عملياً سرّ وجوده في الكرملين منذ عام 2000، عنصرا وفيّا لعقيدة سوفييتية بعناوين روسية. ولم يكن غريباً تطرّقه في خطابه إلى أفعال الزعيمين السوفييتيين، فلاديمير لينين وجوزيف ستالين، لتبرير حقيقة “وجود” أوكرانيا من عدمه، ومعتبراً أنها جزء من روسيا “الطبيعية”. استعان بوتين بالتاريخ لتبرير الحركية الجغرافية، عبر غزو جيشه جارته الغربية، في سياق مبدأ “مواجهة الأميركيين”. وهذا التاريخ يُشكّل نقطة انطلاق للرئيس الروسي في أي حراكٍ مستقبلي، قد يطاول دولاً سوفييتية سابقة، عكس ما يوحي. إقليم السوديت في تشيكوسلوفاكيا السابقة الذي ضمّته ألمانيا النازية عام 1938 شاهد على ذلك. وفي وصفه حكام كييف بـ”النازيين”، أعاد بوتين التذكير بفكرة راسخة في عقل الروس، الذين يعدّون ألمانيا النازية عدوّهم التاريخي الأكبر، ودفعوا أثماناً باهظة لتحرير بلادهم منها، ثم المساهمة في تحرير العالم من أدولف هتلر في برلين. بعدها، باشر غزواً كان متوقعاً منذ فترة طويلة، أول من أمس الخميس، معتبراً أن “لا بديل عنه لحماية روسيا”.
لنعد قليلاً إلى الوراء، ما الذي تعنيه الاستعانة بالتاريخ عموماً؟ عادة، من يستعين به لإسباغ المشروعية على عملٍ ما يهدف، بالدرجة الأولى، إلى إزالة الشعور بالذنب الذي يرافق هذا العمل. يعلم بوتين أنه أخطأ، إذ تكفي إشارته في اليومين التاليين لخطابه إلى “حق الدول السوفييتية السابقة بالاستقلال، لكن أوكرانيا هي استثناء”، فضلاً عن أنه تحدّث مراراً عن الأميركيين الذين باتوا على عتبة بابه. طبعاً، يثير تمدّد حلف شمال الأطلسي مخاوف روسيا. في المقابل، “يُمكن” لبوتين الإشارة إلى هذا التمدّد من أجل تكريس توجّه النظام الروسي إلى مسار أكثر حدّةً ضد المعارضين في الداخل، في ظلّ تدهور اقتصادي غير مسبوق في عهده.
ليس التاريخ مقدّساً، وثباته متأتٍ من حركيته، على قاعدة أن الجمود في مساره يؤدّي إلى موته ونشوء فراغات ستملأها أطرافٌ قوية. وفي حالة ما بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، أدّت هذه الفراغات إلى استقلال 15 دولة عنه. كما أن التاريخ ليس “سوى وجهة نظر”، إذا ما كُتِبَ بأقلام المنتصرين، الذين في وسعهم توظيف آلاف المؤرخين لترسيخ أحقيتهم بأراضٍ وشعوب، وطمس حقائق معاكسة لنواياهم. الآن، كيف يُمكن تجاوز جمود التاريخ وعدم إفساح المجال أمام نزاعات مستقبلية تُراق فيها الدماء، في ظلّ التمسّك بمبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها”؟ يبدأ كل شيء بالفرد ثم المجتمع، فإذا أرادت مجموعةٌ ما نيل الاستقلال عن بلد ما، لأسبابٍ غير متعلقة بتدخلات خارجية، يُمكن فعل ذلك بحوار مع الحكم المركزي وإجراء استفتاء شعبي لهذا الغرض، أو أقله الاتفاق على حكم ذاتي في سياق بلد فيدرالي. أما غير ذلك، فإن الحروب ستتناسل، وستؤدي إلى مزيد من التفكك المجتمعي والإنساني، ناهيك عن لجم التطوّر الفكري بناء على أدوات تفكير منطقية حسب ما يُفترض، والافتراض غير حتمي، طالما يجري استغلال تلك الأدوات وتحريفها، أن يقرّب الشعوب من بعضها بعضا على قاعدة “حق الإنسان أولاً”، لا “حق استعباد إنسان من أجل حكم آخر”.
المشكلة لدى معتنقي التاريخ كعقيدة لحكمٍ حالي أنهم يخسرون دائماً، وخسارتهم ناجمة عن اعتقادهم بأن هذه العقيدة كفيلةٌ بتحفيز مشاعر دينية وقومية والهيمنة على عقول الناس بحجّة أنها “محقّة”. لكنهم يدركون أن ابتعاد الناس عن العقائد التي تفرزهم إلى قوى متحاربة لم يعد حلماً.
العربي الجديد
————————

وداعاً أوكرانيا..وداعاً سوريا..وداعاً أيها الكوكب/ عمر قدور
منذ إعلان بوتين الحرب صار ممكناً القول: وداعاً أوكرانيا المستقلة الديموقراطية. الهدف الذي حدده سفاح غروزني وسوريا “…إلخ” هو تجريد أوكرانيا نهائياً من القدرات العسكرية، وإسقاط الحكم المنتخب فيها. ليس من التشاؤم القول أن السفاح سيحقق أهدافه المعلنة وغير المعلنة، فهو أصلاً لم يعلن عنها بطريقة رمي القفازات إلا وقد استعد جيداً. قد تتكبد قواته خسائر تبدو غير محسوبة؛ هذا على الأرجح محسوب أيضاً، وإذا بدأ بالظهور فستتكفل آلته العسكرية بإيقاع الدمار الشامل، ولا أحبّ على قلبه من سياسة الأرض المحروقة.
في الخطوط العريضة العامة، كان كل شيء مكشوفاً في الأسابيع الماضية، فالحشود العسكرية الروسية واضحة كاستعداد لعملية كبرى، والتقارير الاستخباراتية الغربية أكدت حصول غزو وشيك، ومفاوضات اللحظة الأخيرة بين بوتين والغرب كانت معلنة أيضاً. لا مؤامرة سرية، وحتى قبل إطلاق نفير الحرب كان لسان حال التأكيدات الغربية على قرب الغزو هو: وداعاً أوكرانيا. التهديد بالعقوبات الاقتصادية، من دون تأويله مؤامراتياً، كان تلويحة وداع أخرى، إذ تتدنى المخاطرة كلما عُرفت عواقبها مهما كانت شديدة.
طريق سهل جداً عبَره بوتين إلى كييف، من اجتياح جورجيا عام2008 إلى الاستيلاء على القرم عام 2014، مروراً بالاستيلاء على سوريا، قبل العودة إلى غزو أوكرانيا، من دون احتساب الفظائع الأسبق التي ارتكبها في الشيشان وأفغانستان. فُرض بعض العقوبات الغربية عليه بسبب الاستيلاء على القرم، بينما حظي بتساهل قلّ نظيره على احتلاله سوريا، إن لم يكن بدعم ضمني واسع. إنه، في حربه الحالية، غير مسؤول عن دهشة العالم من عدوانه، إنْ كان هناك من دهشة.
بعد سنة من الاستيلاء على القرم، أرسل بوتين قواته إلى سوريا، متشجعاً بالحد الأدنى من العقوبات الذي فُرض عليه. ربما لا يبارح ذاكرة العديد من السوريين، على مختلف توجهاتهم، خروج الوزير لافروف ونظيره الأمريكي كيري من اجتماعات مطوّلة متعلقة بالشأن السوري وضحكاتهما ملء وجهيهما، أو تشابك يديهما في دلالة على الانسجام التام. ذلك “الغرام” كان يطوي فعلياً العقوبات الغربية المرتبطة بالقرم، كانت يداهما المتشابكتان تلوّحان بالوداع للتغيير في سوريا، وبقبول بقاء الاحتلال الروسي على ضفاف المتوسط لأول مرة منذ بدأت الطموحات الإمبراطورية الروسية.
الآن، الثمن المعلن لاحتلال أوكرانيا شبه واضح. المتفق عليه عقوبات اقتصادية فعّالة، لا تتضمن إبعاد روسيا من النظام المالي العالمي “سويفت”. برلين ليست متشجعة لعقوبات أقسى، وهي بالكاد قررت وقف العمل في أنبوب الغاز الروسي. ماكرون لم يشأ إغلاق باب الحوار مع بوتين، رغم تجريبه الحوار قبل أيام، حيث خدعه بوتين بالنقاش في تنفيذ اتفاقيات مينسك بينما كان يشرع في وضع اللمسات الأخيرة للحرب.
نبرة واشنطن غير مرتفعة، إذا قارناها بلندن. تل أبيب، بعد إدانة غير قاسية، تراجعت لتوحي بأن إدانتها لا تتجاوز التعبير البروتوكولي. عندما كانت طلائع القوات الروسية تهاجم شرق أوكرانيا كانت الصواريخ الإسرائيلية تضرب أهدافاً إيرانية بالقرب من دمشق، وإسرائيل لا تريد التفريط بحرية حركتها في سوريا التي ستفقدها بفقدان التنسيق مع موسكو.
الأخبار القادمة من فيينا، قبل طغيان الخبر الأوكراني، أفادت بأيام حاسمة لإنقاذ أو عدم إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. هي لحظة بوتين أيضاً، ومن المعلوم أن مندوبه في المفاوضات يقوم بدور الوسيط بين إيران والأطراف الغربية، وربما لا غنى عنه لإنقاذ الاتفاق الذي تستميت إدارة بايدن لاستعادته. ثم لا يُستبعد أن تتصلب طهران في موقفها مع إدراك ذلك، ومع المثال الذي يقدّمه احتلال أوكرانيا التي سلّمت مخزونها من الأسلحة النووية بموجب اتفاق بودابست 1994مع تعهد روسيا وأمريكا وبريطانيا باحترام استقلال وسيادة أوكرانيا ضمن حدودها آنذاك “المتضمنة القرم ودونباس وكافة أراضيها”.
حاجة الغرب إلى التعاون مع بوتين في العديد من القضايا تضع سقفاً للعقوبات على روسيا، بمعنى أن العقوبات الاقتصادية لن تصل إلى الحد الأقصى طالما لم يُتخذ قرار حاسم بالتصدي لمطامعه بكافة الوسائل، ومنها تقديم الدعم العسكري الفعّال للمتضررين منها. هذا لا يعني أن العقوبات لن تكون بلا أثر، بل من المتوقع أن تتسبب بالضرر الاقتصادي، من دون أن نكون على موعد قريب مع انهيار الاقتصاد الروسي، وبالطبع مع ملاحظة أن يكون الأذى أولاً من نصيب الشرائح الأضعف في روسيا.
لكي يكون هناك من مضمون حقيقي للحديث الغربي عن عقوبات اقتصادية فتاكة ينبغي أن يكون المتضرر منها عقلانياً، وأن يكون تقييمه له متطابقاً مع التقييم الغربي. تجارب الغرب مع تطبيق العقوبات غير مبشّرة، على الأقل في المدى المتوسط، لأن ظهور الآثار العميقة المستدامة للعقوبات يأخذ وقتاً طويلاً، إذا تم التقيد بها ولم تتأثر بمتغيرات سياسية مقبلة تتعلق بملفات أخرى غير ذاك الذي وضعت بسببه. ومن المؤكد أن بوتين بعد وقت لن يطول سيلجأ إلى ابتزاز الغرب في مكان آخر أو قضية أخرى من أجل التخلص من العقوبات، أو من أجل ما سيسميه البعض “هروباً إلى الأمام”، الهروب الذي لا يُستبعد أن يسحق تطلعات شعب آخر. اليوم مثلاً تتجدد المخاوف من العودة إلى اجتياح جورجيا أو اجتياح مولدوفا، بل هناك خشية من توجه بوتين إلى دول البلطيق المحمية بمظلة الناتو، وحتى فنلندا بدأت التفكير في الخروج من وضعية الحياد والانضمام إلى الناتو لتحظى بحمايته.
هناك متعطش ليكون قيصراً بإمبراطورية واسعة، لا يهم ما إذا كان أحمقاً أو داهية، فهو ينجح حتى الآن مستفيداً من الغرب الذي يتحاشى المواجهة العسكرية ما لم يتهدد أمنه المباشر. لا يهم ما إذا كانت روسيا ستدفع ثمناً باهظاً، وما إذا سيكتب التاريخ بعد عقود سقوطاً جديداً للحلم الإمبراطوري الذي تكرر. المهم أن كوكبَ ما بعد انهيار جدار برلين قد انتهى، وهو الآن على مشارف حقبة شديدة السوء. التلويح للطغاة بعبَر التاريخ لا يعدو كونه حكمة جوفاء، لأن العبَر الأخيرة كتبت بدماء أفغان وشيشان وجورجيين وسوريين وأوكرانيين لتحبط شعوباً أخرى ستخشى المصير نفسه.
المدن
—————————–

سوريا «رهينة» المغامرة الأوكرانية/ إبراهيم حميدي
لا مبالغة في القول إن سوريا ستكون بين الأكثر تأثراً من الهجوم الروسي على أوكرانيا ومآلاته العسكرية والسياسية، سواء نجح الرئيس فلاديمير بوتين في إجراء تحول كبير في الميدان و«تغيير النظام» في كييف، أو غاص في «المستنقع الأوكراني» وووجهت قواته بمقاومة داخلية أو بدعم سري من دول «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) عبر الحدود البولندية.
في الأصل، كان هناك رابط دائم بين الملف السوري وأزمات أخرى، مثل ليبيا وناغورنو قره باخ، في السنوات الأخيرة، باعتبار أن «اللاعبين» هم أنفسهم خصوصاً تركيا وروسيا. وكثيراً ما كان الطرفان يتبادلان الضربات في جبهة لإيصال «رسائل» في جبهة أخرى لإنجاز مقايضات جيوسياسية. لكن الرابط العسكري الأوضح هو بين أوكرانيا وسوريا، وهنا بعض الأسباب:
أولا، الأسد – يانوكوفيتش: بعد هروب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا في فبراير (شباط) 2014، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «الثورة الملونة» بضم شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) من العام نفسه. كما أن موسكو طلبت من دمشق التشدد في عملية السلام في جنيف التي كانت تجري برعاية الأمم المتحدة وعدم المرونة أمام طلبات «الثورة الملونة» في سوريا. وفي أحد الاجتماعات، أبلغ الرئيس بشار الأسد نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أنه لن يكون مثل يانوكوفيتش الذي هرب خلال أيام، بل قرر «البقاء والصمود».
ثانياً، التدخل العسكري: بعد اعتراض موسكو على التدخل الغربي في العراق وليبيا، وبناء على طلب سري من موفد الأسد إلى الكرملين وطلبات أخرى من طهران في 2015، قرر الرئيس بوتين الانخراط العسكري في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015 لوقف انتكاسات القوات السورية ومنع «تغيير النظام». في المقابل، حصلت روسيا على امتيازات عسكرية كبيرة أهمها تأسيس قاعدة عسكرية دائمة في حميميم بريف اللاذقية وقاعدة بحرية في ميناء طرطوس.
لم تقلب روسيا ميزان القوى العسكرية في سوريا بحيث ارتفعت حصة القوات النظامية من السيطرة على الأرض من 10 في المائة إلى 65 في المائة وحسب، بل إن الجيش الروسي استعمل الأراضي السورية مختبراً لتجربة 350 نوعاً من المعدات والأسلحة العسكرية في المعارك. ولوحظ أن مشاهد بعض المعارك في أوكرانيا حالياً تشبه إلى حد كبير مشاهد المعارك في وسط سوريا وغربها في 2016.
ثالثاً، المياه الدافئة: وجود روسيا على مياه البحر المتوسط، كان حلماً قيصرياً روسياً قديماً، تحقق بتحويل ميناء صغير في طرطوس إلى قاعدة بحرية وإقامة قاعدة عسكرية قرب حدود «الناتو» في تركيا. وأبرز استعراض لهذا «الإنجاز الاستراتيجي» كان عشية بدء الهجوم على أوكرانيا، إذ جرت أكبر مناورات بحرية في البحر المتوسط الذي كان يشهد مناورات لـ«الناتو». يضاف إلى ذلك، أنه قبل المناورات زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قاعدة حميميم والتقى الأسد، وكانت هذه إشارة واضحة إلى أن موسكو باتت تعتبر سوريا «امتداداً لأمنها القومي».
رابعاً، إشارات رمزية: لم تكن صدفة أن يكون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في موسكو، يوم اعتراف بوتين بـ«استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك»، الذي اعتبره المقداد منسجماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ولاحقاً، أشاد الأسد بالهجوم على أوكرانيا باعتباره «تصحيحاً للتاريخ» بعد «تفكك الاتحاد السوفياتي». وكانت سوريا أيضاً وقعت اتفاقات لربط ميناء اللاذقية بشبه جزيرة القرم، واعترفت بجمهوريات انفصالية كثيرة تدور في فلك موسكو، وكلها إشارات إلى أن سوريا «جزء من العالم الروسي» الذي يريده بوتين.
خامساً، رأس حربة: تعتبر موسكو قاعدة حميميم التي تضم منظومات صواريخ «إس 400» و«إس 300»، رأس حربة في المواجهة مع «الناتو» الذي يقيم قاعدة في انجرليك جنوب تركيا. واستطاع بوتين كسب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المصاب بخيبة من السياسة الأميركية ودعمها للأكراد شرق سوريا، إلى جانبه. وأوضح مثال على ذلك، أن أنقرة رفضت إغلاق ممر البوسفور أمام مرور السفن العسكرية الروسية باتجاه السواحل الجنوبية لأوكرانيا. في المقابل، رفض شويغو طلباً سورياً خلال زيارته الأخيرة بإعطاء الضوء الأخضر لهجوم شامل في إدلب، حسب معلومات.
سادساً، «القبة الحديدية»: الحذر في التعاطي مع الهجوم الروسي في أوكرانيا، لم يكن تركياً فقط، بل إن إسرائيل كانت حذرة بدورها، حيث أفادت تقارير عن عدم تقديم تل أبيب دعماً عسكرياً لكييف خوفاً من إغضاب بوتين وتقييد أيدي إسرائيل في غاراتها على «مواقع إيرانية» في سوريا، خصوصاً وسط تقارير عن احتمال أن يكون إحدى ثمار الحرب الأوكرانية تقارب إضافي روسي – إيراني.
سابعا، خطوط التماس: لم تتغير «الحدود» بين مناطق النفوذ السورية الثلاث خلال سنتين، لكن المواجهة الأوكرانية تطرح أسئلة عن إمكانية تعرضها لاختبارات كثيرة. واشنطن أعلنت أن اتفاق «منع الصدام» بين الجيشين لا يزال قائماً. وموسكو رفضت طلب دمشق شن هجوم على إدلب. لكن لا شك أن مستقبل هذه «التفاهمات» مرتبط بمسار الأوضاع في أوكرانيا ومدى قدرة موسكو وواشنطن على عزل المسارات بين الملفات المختلفة. وينطبق هذا أيضاً على تفاهم البلدين على قرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتمديده.
ثامناً، ثمن اقتصادي: لا تقتصر آثار الرياح الأوكرانية على البعد العسكري والسياسي في سوريا، بل هناك آثار اقتصادية كثيرة، خصوصاً أن دمشق تعتمد بشكل كبير على الدعم الغذائي والنفطي من موسكو لمواجهة العقوبات الغربية عليها. موسكو في الأيام المقبلة، مشغولة جداً بملفها الساخن، لذلك لم يكن أمام دمشق سوى اتخاذ قرار بـ«شد الأحزمة» أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
لا شك أن مستقبل «خطوط التماس» ووقف النار والمساعدات الإنسانية والغارات الإسرائيلية والأوضاع الاقتصادية، بات مرتبطا بمآلات شرق أوروبا… كأن سوريا أصبحت «رهينة» مغامرة بوتين في أوكرانيا.
الشرق الأوسط
——————————-
تفاصيل العقوبات ونوعها: روسيا إلى سيناريوهات كارثية مالياً وتكنولوجياً/ علي نور الدين
لم تبلغ الأمور بعد حد عزل روسيا كليًّا عن الاقتصاد العالمي، إذ يبدو أن هذه الخطوة الأخيرة ستبقى معلّقة بانتظار البت بمسألة إخراج روسيا من نظام “السويفت” المعتمَد عالميًا للتحويلات البنكية، وهي خطوة تعارضها ألمانيا حتّى اللحظة. لكن الأكيد حتّى اللحظة أيضاً، هو أن العقوبات التي توالى فرضها خلال الأيّام الماضية كفيلة بدفع روسيا تدريجيًّا نحو إقصاء مالي لم تشهده روسيا من قبل. وإذا تمكّنت دول العالم من إقناع ألمانيا بإخراج روسيا من نظام “السويفت”، فستكون روسيا أمام سيناريوهات كارثيّة على المستوى الاقتصادي، وتحديدًا من جهة قدرة الشركات الروسيّة على إجراء أبسط العمليّات الماليّة والتجاريّة مع سائر دول العالم.
العقوبات المفروضة حتّى اللحظة
أقسى العقوبات التي تم فرضها على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، تمثّلت في تلك التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركيّة على 13 شركة ومؤسسة روسيّة، بينها كبرى المؤسسات الماليّة والمصرفيّة، بالإضافة إلى شركات طاقة معروفة كغازبروم. حساسيّة العقوبات الأميركيّة، تكمن في قدرتها على عزل هذه المؤسسات عن النظام المالي الأميركي، ومنعها من إتمام أي تحويلات أو صفقات يمكن أن تمر بالمصارف الأميركيّة كوسيط مراسل. وبما أن جميع التحويلات الماليّة المقوّمة بالدولار تمرّ في نهاية من ضمن النظام المالي الأميركي، الذي يلعب دور الوسيط في هذه التحويلات، فهذه الخطوة ستعني ببساطة منع هذه المصارف والشركات من إتمام الصفقات المقوّمة بالدولار الأميركي.
مع الإشارة إلى أن العقوبات الأميركيّة شملت منع تزويد الشركات الروسيّة بتكنولوجيّات متنوّعة مثل أجهزة الإتصال واللايزر وأجهزة الملاحة وإلكترونيات الطيران وتقنيّات الإبحار والخرائط البحريّة وأمن التشفير وأجهزة الاستشعار. ومنع روسيا من الولوج إلى هذه المعدات التي يمكن استخدامها لغايات عسكريّة، سيكون له أثر بالغ على صناعات وقطاعات أخرى لا ترتبط بالأنشطة العسكريّة بالضرورة، كقطاع الاتصالات والمواصلات البريّة والبحريّة والطيران وغيرها. ولهذا السبب، من المرتقب أن تعاني الكثير من الشركات الصناعيّة الروسيّة من تقاطع أزمتين في الوقت نفسه: عجزها عن الوصول إلى التكنولوجيّات المتطوّرة التي تحتاجها في نشاطها الصناعي، وعرقلة عمليّاتها الماليّة نتيجة العقوبات المفروضة على كبرى المصارف الروسيّة، التي كانت تمثّل الوسيط ما بين النظام المصرفي الروسي والمصارف المراسلة العالميّة.
الضربة الماليّة الثانية أتت من المملكة المتحدة، التي تملك حصّة وازنة من التداولات الماليّة العالميّة، والتي تستحوذها سوقها الماليّة وحدها على 37% من عمليّات القطع التي تجري في جميع أنحاء العالم. العقوبات البريطانيا توسّعت لتشمل أكثر من 100 فرد وشركة روسيّة من جميع القطاعات الاقتصاديّة، بما فيها القطاع المصرفي الروسي، بهدف “عزل المصارف الروسيّة عن النظام المالي في المملكة المتحدة” على حد قول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كما من المفترض أن تشمل العقوبات البريطانيا تجميد الأصول المصرفيّة والعقاريّة التي تملكها هذه الكيانات، بالإضافة إلى أي استثمارات تخصّها في السوق الماليّة البريطانيّة.
أما العقوبات التي ذهب باتجاهها الاتحاد الأوروبي بالتحديد، فتوسّعت لتستهدف عزل 70% من النظام المصرفي الروسي عن السوق الأوروبيّة، بالإضافة إلى قطاعي المواصلات والطاقة، وهو ما يفترض أن يمنع الروس من تطوير المنشآت النفطيّة التي تمثّل عصب الصادرات الروسيّة. وهذه العقوبات بالتحديد، ستترك أثراً كبيراً على النخبة الماليّة الروسيّة المقرّبة من بوتين، التي اعتادت طوال العقود الماضية على استعمال الأنظمة المصرفيّة الأوروبيّة كجنّة ماليّة للاحتفاظ بالودائع وإجراء العمليّات الماليّة. مع العلم أن العقوبات الأوروبيّة استهدفت أيضًا بعض القطاعات الحسّاسة بالنسبة إلى روسيا، كقطع غيار الطيران وتكنولوجيا المواصلات والاتصالات، وهو ما يفترض أن يترك أثراً بالغاً على الصناعات العسكريّة الروسيّة.
يُضاف إلى جميع هذه العقوبات، الإجراءات العقابيّة التي اتخذتها كل من تايوان واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا، والتي تركّزت جميعها على عزل روسيا عن العمليّات المصرفيّة الروتينيّة التي تشكّل نافذة البلاد الماليّة مع العالم، بالإضافة إلى تضييق الخناق على صناعاتها الحسّاسة بما فيها تلك التي تُعنى بقطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات.
كما بلغت الإجراءات المتخذة ضد روسيا حد تعليق عقد نوردستيم 2 من قبل ألماتيا، الذي يُعنى بخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط روسيا بألمانيا والذي أُنجز بناؤه في شهر أيلول الماضي، بكلفة تجاوزت 11.13 مليار دولار. وحسب العقد، كان من المفترض أن يتم تزويد السوق الأوروبيّة من خلال هذا الخط بنحو 55 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما كان سيفتح المجال لروسيا لزيادة عائداتها من تصدير الغاز الطبيعي من جهة، ولزيادة نفوذها وأدوات ضغطها على الأوروبيين من جهة أخرى. مع الإشارة إلى أن العقد –المعلّق حاليًّا- نص على تسليم إدارة خط الانابيب هذا إلى شركة غازبروم الروسيّة العملاقة، التي باتت اليوم تحت مقصلة العقوبات الجديدة.
ضربة الإقصاء من نظام “سويفت”.. إذا تمّت
يذكر خبراء الأسواق الماليّة كيف خسرت إيران سنة 2012 أكثر من نصف عائداتها من تصدير الغاز والنفط، ونحو 30% من عائدات تجارتها الخارجيّة، بمجرّد حظرها من النظام السويفت العالمي. فهذا النظام، المعتمد كشبكة بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة ماليّة عالميّة، يمثّل اليوم الوسيط التقني الأهم لإتمام التحويلات الماليّة بين دول العالم، وإقصاء أي دولة عنه يعني ببساطة حرمانها من الولوج إلى التداولات الماليّة العالميّة بين المصارف. وهذا الإجراء، إذا جرى اتخاذه بحق روسيا، سيمثّل تصعيداً أكثر قسوة من العقوبات التي جرى تطبيقها حتّى اللحظة، لكونه سيبعد الروس عن التعامل مع النظام المالي العالمي بأسره، لا مجرّد الاكتفاء بإبعادهم عن الأنظمة الماليّة للدول التي طبّقت العقوبات.
حتّى اللحظة، تستمر أوكرانيا بالضغط على دول العالم لاتخاذ هذه الخطوة الموجعة، مدعومةً بتأييد كل من بريطانيا وأستونيا وليتوانيا ولاتفيا، فيما تبدي الولايات المتحدة بعض الحذر من هذا المطلب، لعدم وجود إجماع أوروبي حوله. لكن ما يفرمل اتخاذ هذا القرار بالتحديد، ليس سوى التحفّظ الذي تبديه ألمانيا اتجاه هذا المقترح، فيما تبدي فرنسا استعدادها للجوء إلى هذه الخطوة في حال “الضرورة القصوى”. ومن الناحية العمليّة، يرتبط التحفّظ الألماني والتريّث الفرنسي بحاجة الدولتين إلى وجود روسيا ضمن نظام “السويفت”، لإتمام مدفوعات صفقات النفط والغاز مع موسكو، في ظل اعتماد الدولتين على الصادرات الروسيّة البتروليّة.
في كل الحالات، من المرتقب أن تتصاعد حدّة الإجراءات والعقوبات الاقتصاديّة والماليّة المتخذة بحق روسيا خلال الأيام المقبلة، لكن وحسب جميع التجارب مع العقوبات الأوروبيّة والأميركيّة، لن تظهر النتائج الأكثر إيلامًا لهذه العقوبات إلّا مع مرور الأسابيع والأشهر المقبلة. فالنتائج السريعة، من قبيل تدهور سعر صرف الروبل الروسي وأسعار الأسهم في البورصة، ليست سوى نتائج عرضيّة وبسيطة مقارنةً مع النتائج الأكثر قسوة: ضمور القطاعات الاقتصاديّة الروسيّة بشكل متدرّج، بعد حرمانها من أسواقها في الخارج.
——————————
بيدرسن:أعمال اللجنة الدستورية قد تصبح أصعب بسبب غزو أوكرانيا
دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أطراف اللجنة الدستورية إلى تحقيق التوافق والانخراط البناء من قبل جميع الأطراف، معلناً انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 21 آذار/مارس.
وقال بيدرسن في بيان الجمعة، إنه “من المهم أن يستمر عمل اللجنة المصغرة بشكل يسهم في بناء الثقة، هنالك خلافات جوهرية بين مواقف الطرفين، وتضييق الخلافات بينهما يتطلب حتماً عملية تدريجية”.
وأضاف أن “كل ما نحتاج إليه وفقاً للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، هو السعي لتحقيق التوافق والانخراط البناء من قبل جميع الوفود، بحيث يسير عمل اللجنة بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدم المستمر دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج”.
وفي جلسة لمجلس الأمن الجمعة، قال بيدرسن: “أنا قلق للغاية من أن الدبلوماسية الدولية البناءة المطلوبة لدفع هذا الأمر (اللجنة الدستورية) قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية الدائرة حاليا في أوكرانيا”. وأضاف “سأواصل العمل على العملية الأوسع نطاقا لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ويطالب القرار 2254 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما يطلب أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
ولم تحقق الجولات ال6 السابقة التي عقدت اللجنة آخرها في تشرين الأول/أكتوبر، أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا، بسبب تعنت نظام بشار الأسد.
———————
بوتين يدعو الجيش الأوكراني للإطاحة بزيلينسكي..كشرط للحوار
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، العسكريين الأوكرانيين “إلى تولي السلطة” في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس فلاديمير زيلنسكي وأوساطه الذين وصفهم بأنهم “زمرة مدمنين ونازيين جدد”.
وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي: “تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”. وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعاً بشرية”.
ووصف بوتين الرئيس الأوكراني ووزراءه بأنهم “زمرة مدمني مخدرات ونازيين جدد، نصبوا أنفسهم في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله رهينة”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن استعداد روسيا لعقد مفاوضات “رفيعة المستوى” مع أوكرانيا، وفقاً لوكالة أنباء الصين الرسمية.
وقالت محطة التلفزيون المركزي الصيني الجمعة إن الرئيس الصيني دعا نظيره الروسي خلال المكالمة الهاتفية إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة. وأكد شي جين بينغ أن الصين تدعو لتسوية بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات. وأضافت القناة الصينية أن “الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا”.
وأطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني على تاريخ القضية الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في شرق أوكرانيا، بحسب القناة الصينية.
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قال في مؤتمر صحافي إن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن “تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها”.
وأضاف لافروف الجمعة، أن “روسيا سعت لحل دبلوماسي منذ التوقيع على اتفاقيات مينسك عام 2014 التي كان يمكن أن تضمن سيادة أوكرانيا”، متابعاً: “حاولنا إقناع كييف والغرب بتنفيذ اتفاقيات مينسك لكن محاولاتنا لم تلق صدى”، وأردف أننا “مستعدون للتفاوض فقط عند تنفيذ شروط بوتين بأن تلقي أوكرانيا السلاح وتشكل حكومة ممثلة للجميع”، معتبراً أن “النظام الحالي في كييف يخضع للولايات المتحدة والغرب والنازيين الجدد”.
وفي السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن روسيا مستعدة لإرسال وفود إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا، مشيرة الى أن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.
وجاءت التصريحات الروسية رداً على دعوة وجهها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى نظيره الروسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العسكرية.
وقال زيلينسكي في خطاب متلفز باللغة الروسية الجمعة: “أود أن أخاطب رئيس الاتحاد الروسي مرة أخرى..هناك قتال في جميع أنحاء أوكرانيا الآن..دعنا نجلس على طاولة المفاوضات لوقف مقتل الناس”.
Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором заявил, что Россия начала войну не только против Украины, но и против Европы. Он снова предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. pic.twitter.com/R2HjEC3UYO
— Коммерсантъ (@kommersant) February 25, 2022
ودعا زيلينسكي المواطنين الأوروبيين إلى الاحتجاج لإجبار حكوماتهم على مزيد من الإجراءات الحاسمة ضد روسيا. وقال إن “أوروبا لا تزال قادرة على وقف العدوان الروسي إذا تحركت بسرعة”.
وفي وقت سابق الجمعة، صرح الرئيس الأوكراني أن “موسكو ستضطر إلى التحدث مع أوكرانيا عاجلاً أو آجلاً لإنهاء القتال”.
وكان المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك أكد أن بلاده تريد السلام ومستعدة لإجراء محادثات مع روسيا بما في ذلك الوضع المحايد في ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقال بودولياك عبر رسالة نصية لوكالة “رويترز”: “إذا كانت المحادثات ممكنة فيجب إجراؤها..وإذا قالوا في موسكو إنهم يريدون إجراء محادثات بما في ذلك حول الوضع المحايد فنحن لا نخشى ذلك..يمكننا التحدث عن ذلك أيضاً”. وأضاف “استعدادنا للحوار جزء من سعينا الدؤوب لتحقيق السلام”.
وطالبت موسكو منذ فترة طويلة بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو تسمح له بنشر قوات وأسلحة على أراضيها.
————————-

أوروبا تجمّد أصول بوتين ولافروف..وقادتها يختلفون حول نظام “سويفت”
لحقت الولايات المتّحدة بدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأعلنت فرض عقوبات طاولت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرفي لافروف، في خطوة استثنائية في العلاقات الدولية تنمّ على حجم الشرخ الذي أحدثه الهجوم الروسي على أوكرانيا مع النظراء الغربيين.
وأعلن المتحدثه باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وأضافت أن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون “جزءاً” من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف، مستطردة بأنه “عنصر اعتيادي” في العقوبات على شخصيات أجنبية، مكررة أن تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.
وقالت بساكي إن الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فإنّ ذلك سيشكّل “عملاً مروّعاً”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بالإجماع الجمعة، على تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته في دول التكتل، على خلفية الهجوم الروسي على اوكرانيا فجر الخميس، وفق ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة “فرانس برس”.
وأشارت المصادر الاوروبية الى أن العقوبات الجديدة طُرحت خلال قمة أوربية استثنائية الخميس في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعّلها وزراء الخارجية، فيما أبدت ألمانيا وإيطاليا تحفظات الجمعة خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه عدد كبير من القادة الأوروبيين.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تصريحات من بروكسل إن حزمة ثالثة من العقوبات ضد روسيا في الطريق، وأضاف أنه يجب إيقاف معاناة الأبرياء.
كما قرر الأوروبيون إلغاء إمكانية السفر من دون تأشيرات دخول لحاملي جواز السفر الروسي في إطار العقوبات التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس، بحسب “فرانس برس”.
وقال مستشار النمسا كارل نيهامير إن قمة الاتحاد الأوروبي وافقت على الحزمة “الأكثر قساوة في التاريخ” من العقوبات ضد روسيا، مضيفاً أن تلك العقوبات ستكون “مؤلمة” للاتحاد الأوروبي أيضاً.
وتابع أن العقوبات الأوروبية تشمل توريد قطع غيار الطائرات إلى روسيا، بالإضافة إلى فرض قيود على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية، كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إدراج الرئيس الروسي ووزير الخارجية الروسي في قائمة العقوبات، بحسب قوله.
من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوية ألكسندر شالنبرغ إن الاتحاد لن يفرض حظراً على دخول بوتين ولافروف أراضيه، حفاظاً على إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.
كما اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحلفاؤه في دول أوروبا الشمالية على ضرورة فرض “عقوبات إضافية” على موسكو تستهدف خصوصاً “الأوساط المقربة” من بوتين، وفق ما ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية.
وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني إنه خلال اتصال بين جونسون وحلفائه في قوة Joint Expeditionary Force التي تضم عشر دول من بينها دول البلطيق، “اتفق القادة على ضرورة فرض عقوبات إضافية تركز خصوصاً على الأوساط المقربة من الرئيس بوتين”.
وشدد جونسون على “وجوب تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في شكل عاجل”، مضيفاً أن “الافعال الضارة للرئيس بوتين لا يمكن اعتبارها طبيعية أبداً ولا القبول بعدوانه على أوكرانيا كأمر واقع”.
وتأسست القوة المذكورة العام 2012 وتضم دولاً اعضاء في حلف شمال الاطلسي (الدنمارك واستونيا وايسلندا ولاتفيا وهولندا والنروج وبريطانيا) ودولتين ليستا عضوين هما فنلندا والسويد. وتركز اهتمامها على الامن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الاطلسي وبحر البلطيق.
بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على “أعلى قادة روسيا”، في مذكرة وجهها ماكرون إلى البرلمان الفرنسي الجمعة. وقالت المذكرة: “الخميس تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات غير المسبوقة التي تؤثر على روسيا وبيلاروس..وستشمل العقوبات أيضاً مسؤولين روس بمن فيهم أعلى قادة البلاد”.
لكن المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية بيت بارون قالت إن العقوبات المفروضة ضد روسيا ستكون لها عواقب على الاقتصاد الألماني على المدى المتوسط. وقالت بارون: “ستكون لهذه العقوبات عواقب على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد الألماني..بالطبع سيكون هناك ارتفاع في الأسعار ورد فعل على مثل هذه العقوبات”، مضيفةً “يجب أن ندرس عواقب العقوبات على المدى المتوسط بعناية”.
وجاءت هذه الاجراءات تلبية لطلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتعزيز العقوبات الأوروبية ضد روسيا لمعاقبتها على هجومها على أوكرانيا.
نظام سويفت
واللافت أن الغرب لم يقرر أي إجراء لمنع البنوك الروسية من استعمال “سويفت” الذي يعد أداة أساسية في المنظومة المالية الدولية. ويرجع ذلك أساساً إلى مخاوف العديد من الدول الأوروبية بشأن إمداداتها من الطاقة من روسيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت الجمعة إن “قطع سويفت ستكون له تداعيات هائلة على الشركات الألمانية في علاقاتها مع روسيا، ولكن أيضاً على تسوية مدفوعات إمدادات الطاقة”.
لكن فرنسا الأقل اعتماداً على المواد الأولية الروسية أعلنت الجمعة تأييدها استبعاد روسيا من “سويفت”. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مؤتمر يضم وزراء المال في الاتحاد الأوروبي الجمعة، أن “بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظات وفرنسا ليست ضمن هذه الدول”.
وطلب وزراء المال الأوروبيون خلال الاجتماع من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي “تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي”، وفق بيان لهم. وأكد الوزراء أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”.
وأعلنت النمسا أن العقوبات الاقتصادية التي قررها قادة مجموعة السبع الخميس ستؤثر بالفعل على 70 في المئة من معاملات البنوك الروسية ما يجعل حظرها من “سويفت” غير ضروري.
ورحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بكون العقوبات التي أقرّت الخميس “لا تشمل الطاقة”، ما يضمن “إمدادات الطاقة للمجر ودول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي”.
عقوبات انتقامية
وفي المقابل، أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو الجمعة أن روسيا أعدت حزمة من “العقوبات الانتقامية”، وقالت إن “موسكو تعرف أنها نقاط ضعف الغرب”، مضيفةً “روسيا استعدت بشكل جيد للعقوبات واتخذت جميع الإجراءات الوقائية”.
بدوره، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية ضد العقوبات، مضيفاً أن روسيا ستعمل على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الآسيوية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد الخميس أن استبعاد روسيا من “سويفت” يظل “خياراً”، مشيراً إلى أن “الأوروبيين لا يتشاركون هذا الموقف حالياً”.
——————————

المدفوعات الروسية تمثل واحداً في المئة من التعاملات عبره
ما هو نظام سويفت ولماذا ينقسم الغرب حول عقاب روسيا بالحرمان منه؟
– بي. بي. سي.
حذر وزير خارجية أوكرانيا، ديمترو كوليبا، قادة الغرب من “تلطخ أيديهم بالدماء” إذا ما فشلوا في حظر روسيا من نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات، وهو نظام محوري من أجل تعاملات مرنة في المال حول العالم.
وقال كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر: “لن أكون دبلوماسيا حول هذا الأمر، كل من يشك في ضرورة حظر روسيا من نظام سويفت يجب أن يفهم أن دماء الأبرياء من رجال ونساء وأطفال أوكرانيا ستلطخ يديه أيضا”.
وانضم وزراء خارجية بريطانيا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى دعوة كوليبا بوقف عمليات روسيا من خلال النظام المالي العالمي “سويفت”، ولكن دولا أوربية أخرى مترددة في القيام بالخطوة ذاتها.
إذا كيف ستؤثر هذه العقوبات على روسيا، ولماذا هناك خلاف حول فرضها بين الدول الغربية؟
ما هو نظام سويفت؟
نظام “سويفت” هو شريان مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود. و كلمة سويفت – SWIFT – هي اختصار لـ “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة.
ولكن سويفت هو ليس البنك العادي الذي تقابله في أي شارع، فهو نظام مراسلة فوري يخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها.
ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات.
ويعتقد أن المدفوعات الروسية تمثل واحدا في المئة من حجم التعاملات عبر نظام سويفت.
لماذا هناك دعوات لإخراج روسيا من هذا النظام؟
سيؤدي حظر روسيا من التعامل عبر نظام سويفت، والذي يستخدم من قبل الآلاف من البنوك، إلى التأثير على شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال.
لكن العديد من الحكومات يخشى من أن هذه العقوبة ستؤثر على اقتصادياتها وشركاتها، فعلى سبيل المثال شراء الغاز والبترول من روسيا سيتأثر.
وقادت بريطانيا الدعوة لوقف عمل نظام سويفت في روسيا، غير أن بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، قال: “للأسف لا نملك التحكم في نظام سويفت بمفردنا. وقرار كهذا لا يؤخذ بصورة فردية”.
ويقال إن ألمانيا تعارض حظر روسيا من نظام سويفت.
وبصورة متطابقة، فإن وزير المالية الفرنسي برونو لو ميير ورئيس وزراء هولندا مارك روتيه قالا، اليوم الجمعة إن خيار حظر روسيا سيتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح، يوم الخميس، إن الحظر ليس مطروحًا على الطاولة لأنه “في الوقت الحالي ليس هذا هو الموقف الذي ترغب بقية أوروبا في اتخاذه”، رغم أنه أضاف أنه سيظل مطروحًا على الطاولة.
من يملك نظام سويفت ويتحكم فيه؟
أنشىء نظام سويفت من قبل بنوك أمريكية وأوروبية، كانت ترغب في ألا تسيطر مؤسسة واحدة على النظام المالي وتطبق الاحتكار.
والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية.
ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.
يساعد نظام سويفت في جعل التجارة الدولية الآمنة ممكنة لأعضائها، وليس من المفترض أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات.
ومع ذلك، تم حظر إيران من سويفت في عام 2012، كجزء من العقوبات المفروضة على برنامجها النووي.
وخسرت طهران، جراء ذلك، ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 في المئة من التجارة الخارجية.
وتقول سويفت إنها لا تملك أي تأثير على العقوبات وإن أي قرار بفرضها يقع على عاتق الحكومات.
كيف يؤثر ذلك الحظر على روسيا؟
ستفقد الشركات الروسية الدخول للمعاملات السلسة واللحظية التي يوفرها نظام سويفت. وستتأثر المدفوعات الخاصة بمنتجات روسيا المهمة في قطاع الطاقة والزراعة سلبيا بدرجة كبيرة للغاية.
ومن المرجح أن تضطر البنوك إلى التعامل مباشرة مع بعضها البعض، مما يضيف التأخير والتكاليف الإضافية، ويؤدي في النهاية إلى قطع الإيرادات عن الحكومة الروسية.
وكانت روسيا مهددة بالخروج السريع من قبل، في عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم. وقالت روسيا إن الخطوة ستكون بمثابة إعلان حرب.
ولم يواصل الحلفاء الغربيون المضي قدمًا، لكن التهديد دفع روسيا إلى تطوير نظام نقل خاص بها – حديث جدًا -عبر الحدود.
ومع ذلك ، لا يستخدمه حاليًا سوى عدد قليل من الدول الأجنبية.
وللتحضير لمثل هذه العقوبة، أنشأت الحكومة الروسية نظام بطاقات الدفع الوطني المعروف باسم “مير”، وذلك للتعامل مع المدفوعات عبر البطاقات.
لماذا ينقسم الغرب حول سويفت؟
إن إزالة روسيا من هذا النظام من شأنه أن يضر بالشركات التي تزود روسيا بالسلع وتشتري منها، ولا سيما ألمانيا.
فروسيا تعد المزود الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، ولن يكون العثور على إمدادات بديلة أمرًا سهلاً.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل، فإن المزيد من الاضطراب هو أمر تريد العديد من الحكومات تجنبه.
وسيتعين على الشركات الدائنة لروسيا إيجاد طرق بديلة لتحصيل الأموال.
ويقول بعض الناس إن مخاطر حدوث فوضى مصرفية دولية كبيرة للغاية.
وكان أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي السابق، قد قال إن الانقطاع عن نظام سويفت قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد الروسي بنسبة خمسة في المئة.
لكن هناك شكوكاً حول التأثير الدائم على الاقتصاد الروسي، فقد توجه البنوك الروسية المدفوعات عبر دول لم تفرض عقوبات مثل الصين، التي لديها نظام مدفوعات خاص بها.
وهناك بعض الضغط من المشرعين الأمريكيين لفرض حظر، لكن الرئيس بايدن يقول إنه يفضل عقوبات أخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضرر اقتصادات ودول أخرى.
وسيظل قرار وقف وصول روسيا لنظام سويفت بحاجة إلى دعم من الحكومات الأوروبية، التي يتردد الكثير منها بسبب احتمال إلحاق الضرر باقتصادها.
————————-
ما سيناريوهات بوتين لـ«أوكرانيا بعد الغزو»؟
لم يستغرق الأمر سوى بضع ساعات، بدأت يوم (الخميس) الماضي، تمكن خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تمزيق السلام والأمن في أوروبا في محاولته لتجريد الأوكرانيين من حقهم في تقرير المصير.
هجمات جوية وبحرية وبرية، ضمن غزو شامل لأوكرانيا، مستمر حتى اليوم (السبت)، وحذرت مصادر استخباراتية أميركية من أن العاصمة الأوكرانية، كييف، قد تسقط في غضون أيام.
وكان بوتين واضحاً جداً بشأن أهدافه الأساسية من عملية الغزو، فهو يريد نزع سلاح أوكرانيا، وقطع علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإنهاء تطلعات الشعب الأوكراني في الانضمام إلى المعسكر الغربي.
هذه باختصار أهداف بوتين. لكن تخمين كيف بالضبط يخطط بوتين لتنفيذ تلك الأهداف يُعد مسألة شائكة. ورصدت شبكة «سي إن إن» الأميركية سيناريوهات لما يعتزم الرئيس الروسي تنفيذه خلال هذا الغزو.
*تكرار سيناريو ضم القرم
لقد اعترفت الحكومة الروسية بالفعل بـ«جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وهذا الأسبوع، سيطر الجيش الروسي على أجزاء أكبر بكثير من الأراضي، وشن هجوماً حول خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا، وفي الجنوب، حول مدينة خيرسون.
وإذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على مدينة أوديسا الأوكرانية، فمن الممكن تخيل جسر بري يمتد على طول الطريق عبر جنوب أوكرانيا، وربما يربط حتى إقليم ترانسنيستريا الانفصالي في مولدوفا، حيث تتمركز قوات روسية بأوديسا والقرم وجنوب وشرق أوكرانيا.
*تقسيم أوكرانيا
يرى المؤرخ والمؤلف الروسي ألكسندر إتكيند أن تقسيم أوكرانيا خطوة قابلة للتطبيق، وسيجعلها «تبدو مثل ألمانيا في حقبة الحرب الباردة»، حيث يكون غرب أوكرانيا أكثر اعتماداً على أوروبا والغرب، أما الجزء الشرقي فسينضوي في مناطق النفوذ الروسية، والتي تشمل بيلاروسيا.
*دولة مؤيدة لروسيا
يحذر ضباط استخبارات غربيون من أن روسيا تعتزم إسقاط الحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطياً واستبدالها بنظام «دمية» يتحكم فيه الكرملين، وقال بوتين سابقاً إنه يرى أن الحكومة الأوكرانية الحالية «غير شرعية»، وسيجد بوتين بعض الساسة في أوكرانيا الراغبين في قيادة حكومة موالية لموسكو، والتي قد يتم فرضها بالقوة.
*الغزو وفرض الواقع بالقوة
تقول روسيا إنها لا تريد أن تكون بلداً محتلاً لأوكرانيا، لكن من السهل تخيل سيناريو تحاول فيه روسيا فرض قانونها من الحكم القاسي على أوكرانيا، وسيكون من الصعب على الأوكرانيين ابتلاع هذا الأمر والتعايش معه، فهم يعيشون في بلد يتمتع بسياسات محلية حرة وصحافة حرة وتقاليد تحترم الاحتجاج العام في الشوارع بحرية، عكس موسكو.
———————-
ما مدى تأثر الدول العربية من الحرب على أوكرانيا؟/ د. عبد الله الردادي
رغم أن أوكرانيا لا تحتل مرتبة متقدمة في اقتصادات العالم (المرتبة 56)، إلا أن الحرب الروسية عليها سوف تلقي بظلالها بكل تأكيد على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى مكانة أوكرانيا بصفتها إحدى أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في العالم. وتحتل المساحات الزراعية أكثر من ثلثي مساحة أوكرانيا، وتبلغ صادراتها من الذرة أكثر من 4.8 مليار دولار، وزيت زهرة الشمس 3.8 مليار دولار، والقمح 3.11 مليار دولار، أي ما مجموعه 11.7 مليار دولار. ولم تلقب أوكرانيا بـ«سلة خبز أوروبا» عبثاً، فعلى المستوى العالمي، هي تشكل 12 في المائة من إنتاج القمح، و16 في المائة من إنتاج الذرة، و18 في المائة من إنتاج الشعير. وبينما تعد روسيا والصين وألمانيا وبولندا وإيطاليا أبرز الشركاء التجاريين لأوكرانيا، إلا أن العديد من الدول العربية كذلك لديها تبادل تجاري مع أوكرانيا، فما نسبته 12 في المائة من صادراتها تذهب لهذه الدول.
ولأوكرانيا تبادل تجاري مع 18 دولة عربية بلغت قيمته نحو 6.3 مليار دولار في عام 2020؛ تشكل الواردات من أوكرانيا ما نسبته 92 في المائة من هذا التبادل، بينما لا تزيد الصادرات العربية لأوكرانيا على 450 مليون دولار. وتعد مصر والسعودية والعراق والإمارات والمغرب وتونس أبرز الدول ذات التبادل التجاري مع أوكرانيا بمجموع 4.5 مليار دولار لهذه الدول الست. وتحتل مصر الدولة الأولى في الواردات الأوكرانية بأكثر من 1.6 مليار دولار، ثلثاها من الذرة والقمح. وتأتي السعودية بالمرتبة الثانية في الشراكات التجارية العربية الأوكرانية مستوردة ما قيمته 709 ملايين دولار من أوكرانيا، معظمها من اللحوم والشعير والمعادن.
وتبدو مصر في مقدمة الدول التي قد تتأثر من الحرب على أوكرانيا، فهي تأتي في المرتبة السادسة من ناحية وجهة الصادرات الأوكرانية بعد روسيا والصين وألمانيا وبولندا وإيطاليا. ومصر هي الدولة الأولى المستوردة للقمح في العالم، وتستورد نحو 15 في المائة من احتياجها من القمح من أوكرانيا، و55 في المائة من روسيا (أي ما مجموعه 70 في المائة من طرفي الحرب) مما قد يعرض أمنها الغذائي للخطر في حال استمرت الحرب على أوكرانيا، وفُرضت عقوبات اقتصادية على روسيا. إضافة إلى ذلك، فإن مصر تستورد 34 في المائة من احتياجها من الذرة من أوكرانيا بقيمة تزيد على 500 مليون دولار سنوياً.
هذه بعض الآثار المباشرة التي قد ترتب على الدول العربية من آثار الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أكبر من ذلك، فالعديد من الدول العربية تعتمد على الواردات من أوكرانيا في سلاسل الإمداد، لا سيما من الحديد الخام والمعادن، مما قد يؤثر على صناعاتها على المدى البعيد. ولذلك فعلى هذه الدول البدء – إن لم تكن بدأت بالفعل – بالبحث عن بدائل للواردات من أوكرانيا بالمرتبة الأولى وروسيا بالمرتبة الثانية، وذلك تفادياً لأي أثر سلبي قد يترتب على تدفق المنتجات والخدمات من طرفي الحرب.
————–
أوكرانيا.. بوتين يبحث عن انقلاب عسكري/ مصطفى فحص
اختار الرئيس الروسي الحرب، ليس لأن الخيارات الدبلوماسية فشلت في تحقيق مصالحه فلجأ إلى القوه بهدف انتزاع ما يريد. وهل وقع في الكمين؟ أي دُفع إلى خيار الحرب من قبل الغرب الذي أغلق باب التسويات مبكرا مع موسكو، وكأن “الروس والغرب” دفعا معا بهذا الاتجاه، بعدما رفعا سقف شروطهما. فبالنسبة لموسكو أصبح قرار الحرب أقل ضررا من قرار التراجع، وأما الغرب فباتت المواجهة أقل ضررا من تلبية مطالب موسكو غير الواقعية .
إذا كان لا حل إلا بالحرب، إذاً من المبكر القول إن الرئيس بوتين قد وقع بفخ نصبه له الغرب في أوكرانيا. فالغرب الذي غاب عن السمع في ساعات الحرب الأولى يحاول استيعاب الصدمة الأولى، لم يزل يتعامل مع الكارثة وفقا لآلياته البروقراطية البطيئة، وقراراته عالقة ما بين الإجماع ومصالح دوله الخاصة مع روسيا، الأمر الذي عطل عملية الضغط على موسكو، ما أعطى بوتين مزيدا من الوقت من أجل فرض تغيير كبير في الوقائع الميدانية، ولكن بالرغم من غياب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو، لا يبدو بوتين المندفع عسكريا قادرا على استغلال فرصته وحسم المعركة مبكرا.
في كلمته المتلفزة أثناء الاجتماع الثاني لمجلس الأمن القومي الروسي في اليوم الثاني للغزو، لجأ بوتين إلى استخدام ورقته الأساسية “الجيش الأوكراني”، ففي كلمته كان بوتين أكثر وضوحا وصراحة في مطالبته الجيش الأوكراني بالسيطرة على السلطة، هذا المطلب وبهذه السرعة يرتبط بأمرين، الأول سياسيا يستكمل ما بدأه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة الفائت، بأن موسكو مستعدة للتفاوض مع كييف وسترسل وفدا إلى مينسك من أجل هذا الحوار.
أما الثاني استراتيجيا، يكشف أن بوتين يتجنب خوض حرب المدن، فالدخول إلى كييف سيكون مكلفا وسيتسبب بخسائر كبيرة في الأرواح من كلا الجانبين. فعلى الأرجح أن الرأي العام الروسي لن يتقبل عودة عدد كبير من جنوده إلى بلادهم بالتوابيت، كما أنه أيضا يرفض إزهاق أرواح المدنيين في كييف أو أي مدينة أخرى، كما أن احتلال العاصمة الأم للعرق السلافي ومهد كنيسته وتدميرها سيجعل التسوية مع أي سلطة أوكرانية تفرضها موسكو مستقبلا مستحيلة، وستواجه برفض شعبي، وسيعزز الانقسام بين بعض أطراف الشرق وبقية الأوكران، وهذا أقرب إلى حرب أهلية.
من هنا يظهر جليا رهان القيادة الروسية على الجيش الأوكراني لتجنب الوقوع في حقل ألغام تكتيكية واستراتيجية. فالمأزق الروسي سيتسع إذا تأخر الحسم خصوصا إذا صمدت العاصمة كييف، أو أجبرت الروس على دخولها بالقوة ما يعني أن الجيش لن يستسلم وسيخوض معاركه دفاعا عن المدن الأوكرانية، ما يجعل ما تسميه موسكو انتصارا تكتيكيا أشبه بهزيمة استراتيجية. فاحتلال كييف دون السيطرة على كامل التراب الأوكراني سيسمح للجيش الأوكراني الحفاظ على مناطق تحت سيادة الدولة، وهذا قد يدفع موسكو إلى قرار الاحتلال الكامل، ما يتطلب وقتا طويلا وكلفة مادية مرتفعة.
خرج الرئيس الأوكراني وأركان دولته في شوارع العاصمة، ليؤكد قدرة الجيش الأوكراني على المقاومة، وحتى الآن يتجنب بوتين تطبيق نموذجه السوري في الإبادة الجماعية للمدنيين، وهو يعلم أن خطوة التصعيد هذه ستؤدي إلى وحدة الشعب الأوكراني وتماسك القوات المسلحة خلف القيادة السياسية، التي تحاول استيعاب الموجة الأولى من الهجوم، وهي بين خيارين إما الصمود وإما الاستسلام الذي بات يطال هيبة القوات المسلحة بعدما كشفت موسكو عن نواياها تجريد الجيش الأوكراني من السلاح، وهو ما يمس عقيدته القتالية وكرامته الوطنية، ما يعني أن رهان موسكو قد يفشل.
———————–
وعدَتهم بالبقاء وتخلَّت.. من يريد أن يكون حليف الولايات المتحدة بعد اليوم؟/ خالد الحج
باستثناء الاحتلال الإسرائيلي، تبدو علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها من أقصى المحيط الأطلسي حتى البحر الأصفر كعلاقة الحب من طرف واحد، وحيث تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الرجل الذكوري السلطوي الأناني، فمن كاركاس إلى الربيع العربي مروراً بـ14 آذار في لبنان، صعوداً نحو سوريا والمسلحين الأكراد، وعودة إلى رجل أمريكا الأول في الشرق الشاه محمد رضا بهلوي، نزولاً عند السعودية والخليج العربي، ووصولاً عند كوريا الشمالية والصين وغيرها الكثير من المحطات التاريخية التي إن أثبتت شيئاً فهي تثبت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلفائها التي دائماً ما تنتهي بمشهد حلفائها الذين يجدون أنفسهم أمام حبل مشنقة أو منفيين أو في السجون. لتتفوق الولايات المتحدة الأمريكية بذلك في صياغة البيانات والتهديد، لكنها أصبحت تشبه اليوم الثور العجوز الذي يتغنى بطول قرونه وقوة عضلاته سابقاً لكنه يعاني حتى في الوقوف اليوم.
“عملية الخازوق”
يعتبر شاه إيران محمد رضا بهلوي المثل التاريخي الأبرز على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الحلفاء، فإمبراطور إيران الذي قدّم لواشنطن الغالي والنفيس، ونفذ سياستها في المنطقة واتبع تعليماتها، قاوم الإغراءات التي قدمها الاتحاد السوفييتي في سبيل إخلاصه لواشنطن، وعند الامتحان الحقيقي أرسل كبير مستشاري الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي رسالة دعم: “لا تقلق نحن معك ولن يستطيع أحد تحريكك من فوق كرسي الحكم. نحن نرتّب لكي يكون ابنك هو الحاكم القادم لإيران”.
بعدها بساعات خرج من طهران هارباً، ليجدهم أقفَلوا جميع الخطوط في وجهه وضيقوا عليه البلدان، فلم يستطع حتى التواصل معهم، حتى أبناؤه مُنعوا من العودة إلى مقاعدهم الدراسية، والألم الأكبر -كما يقول محمد حسنين هيكل- أن الشاه اكتشف أن هناك اسماً رمزياً كانت تطلقه الولايات المتحدة الأمريكية على تحركاته في أوراق الإدارة الأمريكية ووثائقها، وأن هذا الاسم ألصق به منذ لحظة مغادرته لطهران. وعرف أن هذا الاسم الرمزي كان بالحرف “عملية الخازوق”، وحين وصل إلى مصر هارباً استقبله الرئيس المصري السادات والدموع في عينيه يقول: “لقد عرفت أنهم كانوا طول الوقت يسمونني الخازوق”.
“قولي لواشنطن أن تكون قوية، وليس لي”
لبنان يعتبر من أبرز الساحات التي وقعت في الكثير من الأحيان تحت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى حلفاؤها ضرباتها أكثر من خصومهم، فمن كميل شمعون الذي وجد نفسه سنة 1958 أن حليفته مع خروجه من الحكم أكثر من خصومه، وتوالى هذا النمط حتى التاريخ المعاصر، فمع اشتعال الساحة اللبنانية سنة 2008 في بيروت بما سيعرف لاحقاً باسم أحداث السابع من أيار، التي وقعت بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية “14 آذار” بأغلبيتهم النيابية والعددية، مقابل “8 آذار” حلفاء إيران.
وعندما اندلع القتال بين الطرفين وجد أقطاب 14 آذار أنفسهم بلا حول ولا قوة، حتى حليفتهم الأقوى في العالم لم تصدر بياناً إلا بعد أيام من القتال، وحتى حين صدر بيان جاء بصيغة لا ترقى للحدث وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى انتقاد التعبير الذي استخدمه البيت الأبيض، وقال لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ميشيل سيسون في تسريبات ويكيليكس بلهجة ساخرة -حيث اكتفوا باستخدام “نأمل”-: “ما هذا؟ الأمل لن يردع سوريا”.
ثم ثار على طلب السفيرة حين طلبت منه أن يكون قوياً فقال: “لا أعرف ماذا تنتظرون؟ قولي لواشنطن أن تكون قوية، وليس لي!”، وبعد أيام استطاع حزب الله تحقيق انتصار عسكري واستطاع فرض سياسته في اتفاق الدوحة، فيما عاد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية خاليي الوفاض.
“جعلوا مني كبش فداء”
لعل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، المثال الأبرز على استخفاف الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها، الرجل الذي كاد يجد نفسه أضحيةً لانتصار طالبان، ويلقى مصير الرئيس الأسبق نجيب الله عام 1996 على حبل المشنقة.
استطاع غني أن يهرب تاركاً خلفه اتفاقاً بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية لم يعلم بتفاصيله إلا عبر مستشاريه الذين أخبروه بأن قوات طالبان على تخوم العاصمة، ووجد الجيش الأفغاني الذي كان يحرس القوات الأمريكية أن القواعد التي يحرسها فارغة وأنهم تُركوا لمصيرهم، وبعد أشهر من هروبه قال أشرف غني في تصريح صحفي: “جعلوا مني كبش فداء”.
قد لا تكفي الحديثَ مجلداتٌ عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلفائها، فمن الأكراد في سوريا والعراق مروراً بالربيع العربي من ليبيا وتونس ومصر وسوريا وغيرها، وصولاً إلى أوكرانيا اليوم هي السياسة نفسها، نفس الأسلوب، خطابات وعقوبات، يقف الرئيس الأوكراني كما وقف الكثير قبله، يجر خلفه آماله وأحلامه التي بناها على وعود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية حتى قال: “تُركنا وحدنا والعالم يشاهد فقط”.
قد يكون المشهد الأوكراني اليوم إيذاناً بتحول كبير للسياسة الدولية، والسؤال الأبرز اليوم كيف سيتصرف حلفاء أمريكا في تايوان والتي تبدو الصين تراقب التجربة الروسية وتتشجع لتجربتها الخاصة، كيف سيتصرف حلفاء الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية والخليج العربي وغيرها من دول العالم.
——————————–
الحرب الروسية على أوكرانيا تضع الصين في “مأزق”
وضعت الحرب الروسية على أوكرانيا الصين في “مأزق وموقف محرج” بعد امتناعها على التنديد بهذا العدوان وهو ما يتعارض مع ما تعلنه أن سيادة الدول “أمر مقدس”، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ويقف نهج موسكو على نقيض صارخ من موقف السياسة الخارجية المعلنة للصين والقاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وانتهجت بكين مسارا دبلوماسيا حذرا في الأزمة ورفضت اعتبار العملية “غزوا”، كما لم تستنكر أعمال روسيا، حليفتها الوثيقة.
وأثار موقف بكين غضب قادة أوروبا وزاد من إحباط واشنطن تجاه الصين. كما أدانت الدول الآسيوية والأفريقية المقربة تقليديا من بكين تصرفات روسيا.
وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تأييده لحلّ النزاع في أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي.
ونقلت محطة “سي سي تي في” الرسمية الجمعة في تقرير عن المكالمة الهاتفية، عن الرئيس الصيني تأكيده أن “الوضع في شرق أوكرانيا شهد تغيّرات متسارعة … (وإن) الصين تدعم روسيا وأوكرانيا في حل المسألة من خلال مفاوضات”.
نفذت القوات الروسية غزوا ضد أوكرانيا، شمل ضربات جوية وإرسال جنود إلى عمق أراضي هذا البلد، بعد أسابيع على فشل جهود دبلوماسية في ردع بوتين عن شن العملية العسكرية.
وأكد شي في الاتصال الهاتفي مع بوتين على ضرورة “التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وتعليق أهمية على المخاوف الأمنية المنطقية لجميع الدول واحترام تلك المخاوف، وتشكيل آلية أمنية أوروبية فاعلة ومستدامة من خلال المفاوضات”.
مع تصاعد الأزمة، اضطرت الصين إلى تحقيق توازن بين علاقاتها القريبة مع روسيا ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في أوروبا.
وقال شي إن الصين “على استعداد للعمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي للدعوة إلى مفهوم أمني مشترك وشامل ومتعاون ومستدام، وحماية النظام الدولي مع بقاء الأمم المتحدة في الصميم”، وفق النص الذي نشرته “سي سي تي في”.
وقال المحلل السياسي آدم ني، إن “عدم الاتساق يضر بالصين على المدى الطويل”. وأضاف: “يقوض مبادئ السياسة الخارجية الصينية الراسخة، ويجعل من الصعب إبراز نفسها كقوة عظمى مسؤولة”.
وأكد أن الدول الأوروبية سترى هذه الموقف “ازدواجية وتواطؤ في العدوان الروسي، والذي من المحتمل أن يكون له تكاليف على بكين”.
شارك بعض الأكاديميين الصينيين مخاوفهم دعم الرئيس الصيني لبوتين. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، تساءل بعض المستخدمين بشدة عن موقف الصين في ساحات الحرب في أوكرانيا من خلال مبدأها الراسخ بأن الدول يجب أن تدير مصيرها.
قال أحد النشطاء، الجمعة، على موقع “ويبو” الصيني: “أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة، وإذا أرادت الانضمام إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي، فهذه حريتها ولا يحق لأي شخص آخر التدخل”.
وأكد الخبراء أن هذه الحرب ستعرض مليارات الدولارات الصينية للخطر. وقال ديكستر روبرتس، مؤلف كتاب “هواوي”: “إذا استمر الغزو الروسي، فسيتم تعليق صفقة مدتها 3 سنوات من قبل شركة هواوي العملاقة للشبكات الصينية لتثبيت خدمات الجيل الرابع اللاسلكية في نظام مترو كييف، وستتباطأ الشحنات الزراعية الضخمة أسطورة الرأسمالية الصينية”، بحسب موقع “صوت أميركا“.
أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأوكرانيا في عام 2019، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة المحاماة الأوكرانية Crane IP. ويقدر المحللون التجارة الثنائية اليوم بين 10 مليار دولار و20 مليار دولار سنويًا.
وقال روبرتس إن الصين تبيع الآلات والسلع الاستهلاكية لأوكرانيا ولديها فائض تجاري إجمالي. ووصف التجارة الصينية بأنها “مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا”.
وتصدر أوكرانيا أيضًا سلعًا إلى الصين، مثل الذرة والشعير وزيت عباد الشمس. حيث يأتي حوالي ثلث الذرة في الصين من أوكرانيا.
الحرة / ترجمات – دبي
——————————
الغارديان: على الغرب أن يواجه بوتين ولا يكتفي بالمشاهدة كما فعل في سوريا
أورينت نت – إبراهيم هايل
تناولت صحيفة الغارديان البريطانية الغزو الروسي لأوكرانيا وأوجه التشابه بينه وبين ما جرى في سوريا من قبل، حيث تنامى النفوذ الروسي فيها، في حين وقف الغرب متفرّجاً دون أن يفعل شيئاً.
وقال العقيد السابق بالجيش البريطاني وخبير الأسلحة الكيماوية هاميش دي بريتون-جوردون، في مقال له إن الغرب “تراجع واكتفى بالمشاهدة في سوريا، ولا يجب أن يفعل الشيء نفسه في أوكرانيا، وحان الوقت للولايات المتحدة وحلفائها لإظهار قوتهم في مواجهة عدوان بوتين. لقد تعلّمنا أنه لا يوجد حل آخر”.
على الغرب أن يأخذ العِبَر من سوريا
وأضاف أن الأزمة السورية مستمرة دون أن يلاحظها أحد. وعبّر عن اعتقاده بأنها “تحمل دروساً مهمة للغرب حول طبيعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي لم يلاحظها أحد في العالم. وتستمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ظل الدكتاتورية التي ترعاها روسيا حتى مع رغبة بعض القادة المضلَّلين في إعادة بشار الأسد، مهندس هذه الجرائم، إلى المجتمع المقبول”.
وأوضح المقال أنه في الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية في أوكرانيا، هناك دروس يمكن للغرب -بل ويجب عليه- أن يتعلمها من الوضع في سوريا، موضحاً أن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على عكس الأسد، لا يرحّب ببوتين بأذرع مفتوحة.
وتابع قائلاً إنه منذ أن أزالت الأمم المتحدة مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية في عام 2014، واصل الأسد قصف المستشفيات والمدارس، وحرق القرى على الأرض على غرار العصور الوسطى.
وقال إنه “لحسن الحظ، لم نشهد استخدام أسلحة كيماوية منذ أبريل نيسان 2019، لكن سوريا اليوم دولة روسية في كل شيء ما عدا الاسم، والأسد هو دكتاتور دُمية يتحرك بخيوط من موسكو”.
وأكد أن الشعب السوري أظهر صموداً وابتكاراً لا يُضاهى، حتى بعد خذلانهم مراراً وتكراراً، في حين أن الغرب لم يتدخل عندما بدأ النظام بمهاجمة شعبه.
لا يجب فعل نفس الشيء
وأشار الكاتب إلى أن سوريا “تمثّل الآن وجوداً روسياً وإيرانياً كبيراً على حدود أوروبا. وإذا سقطت أوكرانيا أيضاً، فسوف يتحوّل ميزان القوى إلى حد كبير نحو الشرق”.
وقال دي بريتون-جوردون “ننظر إلى سوريا ونعلم أنه كان ينبغي علينا القيام بعمل أفضل. يجب أن تكون هذه المعرفة أساساً لاستجابتنا لعدوان بوتين الآن”.
ويتابع الكاتب المقارنة قائلاً إن الغرب لم يتدخّل عندما بدأ النظام بمهاجمة شعبه. بعد ذلك، أعلنت الولايات المتحدة خطّاً أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها فشلت في التصرف عندما تم تجاوز هذا الخط.. وأخيراً، وقفنا متفرّجين بينما تشقّ روسيا وإيران طريقهما عبر سوريا لإنشاء قاعدة عمليات أمامية على أعتابنا.
وختم دي بريتون-جوردون المقال قائلاً: “سيُحسن قادتنا صنعاً إذا تذكّروا ذلك، وسيكونون أقوياء ومَرِنين لحماية أوكرانيا. لا أستطيع أن أتصوّر أن بعض العقوبات المفروضة على عدد قليل من البنوك والمليارديرات سوف تُزعج بوتين. إنه يفهم فقط القدرة والقوة، لقد حان الوقت لإظهار صلابتنا”.
————————
ماذا بعد نجاح روسيا في غزو أوكرانيا؟/ إبراهيم الجبين
المشهد الذي رأينا الرئيس الروسي وهو يرتبه على لوحات متتالية، ربما هو جديد على بوتين، لكنه ليس جديداً علينا في الشرق الأوسط. فقد كان التحضير لعمليات انتحارية من هذا النوع يجري كل مرة، حين يـقرِّر ديكتاتور متفرِّد بالقرار مجنون بالقوة والعظمة تفصيل خطة حمقاء ستقوده إلى الانهيار، ولم يكن قرار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعيداً عن هذا الدأب. فقد رسم بنفسه مسار انهيار نظامه وتدمير البوابة الشرقية للعالم العربي فقط بالحماقة الذاتية ووَهْم القوة.
بوتين جمع مستشاريه ومجلس أمنه ، وقبل ذلك أظهر أن البرلمان الروسي يناشده الاعترافَ بالإقليميْنِ الانفصالييْنِ في أوكرانيا، بمعنى آخر أراد أن يقول هو ليس قراري لكني أستجيب لرغبة الآخرين، وباعتباره والد الأمة والأب الجبار فقد قرر أن يكون عطوفاً على المواطنين الروس، الذين منحهم بنفسه الجنسية في أوكرانيا، لحمايتهم من الإبادة المزعومة.
الآن وقع أسوأ الاحتمالات المعروفة مسبقاً، والتي فضحتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وسط إنكار روسي هزلي. وها هو بوتين يغزو أوكرانيا.
الحديث يجري عن الناتو، وعن أن الغرب بقيادة أميركا، لن يسمح بالمس بأي عضو من أعضاء الحلف، لكنه يتعهّد بالصوت العالي، بأنه لن يحرّك جندياً واحداً للدفاع عن دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. وفي مثل هذه المعادلة، لم يعد مفهوماً من الأهم، عضوية حلف أم عضوية الأسرة الدولية؟ ولم يعد واضحاً كيف ينظر العالم إلى الشرعية الدولية، هل هي شرعية التحالف المصلحي أم شرعية القانون الدولي؟.
مشهد مسرحي آخر تخرجه واشنطن بالتعاون مع ممثليها وكومبارسها من الدول التي أعلنت تضامُنها مع أوكرانيا وفرضت حزمة عقوبات لا يكترت لها بوتين. وبين المشهدين يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن ما الذي سيخلفه ذلك في حال نجح أو فشل؟.
الغزو الروسي لهذا البلد الذي يعد 44 مليون نسمة مشحونين بمشاعر وطنية عالية وتحت مطارق الروس التي يرونها حاقدة، يفشل بمجرد وقوعه، فالسيناريو المرسوم أوهن من أن يتمكن من الصمود طويلاً، فماذا بعد أن يسيطر الجيش الروسي على هذا البلد؟ سينصّب حكومة موالية له في كييف؟ وماذا بعد؟ كيف سيحميها وكيف سيمنع الأوكرانيين من إسقاطها؟ ليس لديه سوى البقاء كقوة احتلال تقليدية وهي المهمة التي عجزت عنها جميع الجيوش في التاريخ الحديث، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي حين اتبع الأساليب التقليدية.
ستبدأ المقاومة، وهذه المرة هي مقاومة قومية أوكرانية لجيش لا يمتلك أي شرعية، هو أجنبي قادم من خارج الحدود، ليس هذا فقط، بل إن بين الأوكرانيين والروس تاريخاً طويلاً من الاستغلال من جانب واحد لطالما دمّر مقدرات الأوكرانيين وأوهمهم أن في بلادهم مجاعة فيما كانت ثرواتهم تذهب إلى العمق الروسي، مروراً بالكوارث التي أوقعها بهم ومن بينها تشيرنوبل الذي أعاد الروس احتلاله اليوم بعد أن أداروه بطريقة أوقعت كارثة نووية عانت منها أوكرانيا وأوروبا معاً.
ستقاوم أوكرانيا الغزاة الروس وتلطّخ سمعتهم أكثر مما هي ملطخة اليوم بجريمة التدخل في سورية، والتحول الذي يمرّ به بوتين اليوم، من وضعيته السابقة غير المستقرة، إلى العدو رقم واحد في العالم للحرية والديمقراطية وللشعوب التي تنشد الحياة الكريمة، سيقوده إلى المزيد من العزلة، وسيعيد رسم خرائط التحالفات في العالم.
أما النجاح الذي يتوهمه بوتين فهو إنجاز المهمة وسحق أوكرانيا والخروج أقوى مما كان عليه سابقاً. ولا أحد يقول لبوتين إن هذا ليس فقط من سابع المستحيلات بل هو الجزرة التي لوحت له بها الولايات المتحدة في طريقها إلى تطبيق برنامج تحييد روسيا عن الصراع المستقبلي مع الصين.
ستكون روسيا في حالة حرب إلى وقت طويل، بدءاً من فجر الخميس، لحظة تحرك القوات الروسية لغزو أوكرانيا. وحالة الحرب ليست مزحة في الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، ولا يمكن تخيل نتائجها في ظل المستوى الذي أوصل بوتين روسيا إليه، فروسيا ليست بلا شعب، وشعبها لن يحتمل المزيد من المغامرات مهما قمعه بوتين بأجهزته والمافيا التي يتحكم بها.
الهدف الأبعد لبوتين هو إعادة هندسة أمن أوروبا، وليس فقط حماية الأمن القومي الروسي من تهديد الناتو. أي أنه يريد التدخل بعمق في الأمن الأوروبي الذي بدأ بالتحوّل مع العمليات الأولى للغزو الروسي هذا الأسبوع. لديه تصورات عن الساسة الأوروبيين أنهم ليسوا أكثر من ”مثليين ضعفاء“ كما يقول في مجالسه الخاصة، في الوقت الذي يصعّد من الشعور القومي الروسي عبر سيل من الإجراءات والبرامج التي تصب في هدف واحد، إنتاج روسيا قيصرية جديدة تستغل فرصة الضعف الأوروبي. لكن هذا سيخرج الأفاعي من الجحور، ويذكي الحس القومي المتطرف في أوروبا. حينها سيجد بوتين طبقة سياسية أوروبية جديدة لا تقبل بخطابه، بل هي على استعداد لشن الحرب عليه في استعادة حادة للحرب العالمية الثانية بحذافيرها.
الأميركيون يدركون هذا، وهم يديرون اللعبة ببراعة، وسيكون التخلص من عبء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي غنيمة مزدوجة تخلي الساحة لعقود قادمة من الزمن. لكن التاريخ يقول: إن مثل هذه المقامرات لا تجري تماماً كما هو مخطط لها، فهي مرتبطة بتحولات الشعوب التي لم تعد مجرد دمى لا بيد بوتين ولا بيد خصومه. ليس بالشعارات، بل بمتغيرات العصر وثورة التكنولوجيا التي تجعل من استحضار أدوات الماضي التقليدية نوعاً من التدمير الذاتي لا أكثر ولا أقل.
——————————
أوكرانيا تقع في فخّ قرطاجة/ عباس شريفة
يقول غوستاف لوبون في كتابه “روحُ السياسة”: لم يكن القنصلُ الرومي المبعوث إلى قرطاجة مارسيوس سلمياً قائلاً بالمذهب الإنساني، بل كان ممن يعلمون نفسيةَ الأعداء، فعندما اقترب من أبوابِ قرطاجة وهي أرض تونس اليوم -وكانت في حينها أغنى مدنِ العالم القديم وأكثرَها نضارةً في الفنون والتجارة وكان أهلُها من محبي السلام، جلس (مارسيوس) يمتدح فوائد السلام لأهلِ قرطاجة، ويلعن فظائعَ الحرب ثم قال لهم مُستنتِجاً: «ألقُوا سلاحكم وسلِّموه إلي، فستأخذ روما على عاتقها أمرَ حمايتكم».
فاستجابوا لطلبه، ثم قال لهم: «سلموني سفنَكم الحربيةَ، فهي كثيرةٌ عظيمةُ النفقة لا فائدةَ منها بعد أن تعهدت روما بالدفاعِ عنكم ضد أعدائكم». ففعل هؤلاء المسالمون ما أشارَ به عليهم من تسليم السلاح، وهنا قال لهم: «تُحمَدون على خضوعِكم، ولم يبق عليَّ إلا أن أطلب إليكم أن تقوموا بتضحية أخرى وهي أن روما – دفعاً لكل عصيان وخوفاً من أي تمرّد – أمرتني بأن أهدِم قرطاجة، فهي تسمح لكم بالإقامة في أي مكان تختارونه في الصحراء على أن يَبعُدَ فقط ثمانين درجة من البحر المتوسط».
هنالك أدرك القرطاجيون أخطارَ المذهب السلمي، وقد حاولوا عبثاً أن يدافعوا عن أنفسهم، ونتيجةً لمذهب السِّلْم هذا فإن قرطاجة حُرقت بمن فيها من السكان وغابت عن التاريخ نهائياً……
ولعل التاريخ اليوم يعيد نفسه ونحن نرى جحافل الجيش الروسي وطائراته تدكّ المدن الأوكرانية وتدمر مواقعها العسكرية في حرب هجينة شاملة تهدف لإعادة ضمها للاتحاد الروسي بحجة أنها كانت في يوم من الأيام جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية الروسية.
ولعل القادة الأوكرانيين يتجرعون اليوم كأس السمّ وهم يرون بلادهم تهوي تحت الاحتلال الروسي عندما وقّعوا مع روسيا الاتّحادية، وبريطانيا، والولايات المتحدة مذكّرة “بودابست”، 1994 لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية فيما يتعلق بانضمامها إلى معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي كدولة غير حائزة على الأسلحة النووية تنص على احترام سيادتها وعدم استعمال القوة ضدها وحمايتها.
لقد كانت ذريعة القادة الأوكرانيين في تخليهم عن سلاحهم النووي وتسليمه لروسيا هو عدم امتلاك القدرة التقنية للحفاظ على السلاح، فبدلاً أن يدفعهم هذا التحدي لتطوير قدراتهم التقنية وطلب المساعدة من الدول للحفاظ على هذا السلاح الإستراتيجي للدفاع عن النفس اختاروا الطريق الأسهل وهو كسر السيف لأنهم لا يملكون الغمد الذي يحفظه.
ورغم كل الوعود والضمانات المقدَّمة لهم لكن بريطانيا والولايات المتحدة يضربون اليوم بهذا الاتفاق عُرْض الحائط ويتركون أوكرانيا وَحْدَها تواجه مصيرها.
لقد صحا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على وَقْع الفخّ الذي سقطت به أوكرانيا عندما صدَّقت وعود الولايات المتحدة وروسيا المكتوبة على الهواء بعد الاجتياح الروسي لشِبه جزيرة القرم في عام 2014، وهنا بدأت أوكرانيا بإعادة التفكير بإنتاج السلاح النووي، لكن الرئيس الأوكراني عاد وصرح بأنه لا يريد أن تصبح أوكرانيا دولة حائزة على سلاح نووي مرة أخرى. في تصريح كان يحاول أن يرسل برسالة ودّ وتعاطُف لبوتين وخشيةً من أن تؤدي محاولته لإعادة إنتاج السلاح النووي إلى استفزاز روسيا فتعجل باجتياح أوكرانيا لكن الذي حصل اليوم هو الذي كان يخشاه الرئيس الأوكراني مكتفياً بالقول: لا أحد يحارب معنا لقد تُركنا في المعركة وَحْدَنا. ولعل كلمة الرئيس الأوكراني تؤكد أن مَن يخلع أنيابه لا يُقدِّم إثباتاً على حبه للسلام وإنما دليلاً على أنه ضحية سهلة الافتراس.
والحقُّ ما قاله الشاعر أبو القاسم الشابي:
إنَّ السَّلامَ حَقِيقةٌ مَكذُوبةٌ والعَدْلُ فَلْسَفَةُ اللَّهِيبِ الخَابِي
لا عَدْلَ إِلَّا إنْ تعادَلَتِ القُوَى وتَصادَمَ الإِرْهابُ بالإِرْهابِ
——————————–

====================
تحديث 28 شباط 2022
———————–
من الكويت إلى أوكرانيا/ مأمون فندي
في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) عام 1991 وفي تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت بغداد، قررت الولايات المتحدة ومعها التحالف الدولي تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من يوم الغزو. حدث هذا عندما قامت دولة متوسطة القوة مثل العراق بغزو دولة صغيرة هي الكويت، فهل يمنحنا هذا منظوراً لرؤيتنا لغزو دولة نووية كبيرة هي روسيا لدولة أوكرانيا المجاورة، أم أن الزمان ليس هو الزمان، وطبيعة النظام الدولي لم تعد ذاتها بعد أكثر من ثلاثين عاماً؟ ولماذا نتوقع اتخاذ القرارات بشكل أسرع، هل هو العالم السيبراني الجديد الراغب في الإجابات السريعة، أم هي استراحة واسترخاء العقل الاستراتيجي العالمي؟
الاستعجال المسيطر، خصوصاً في منطقتنا العربية، في الحديث عمّا يحدث في أوكرانيا والذي تنقصه في الأغلب المعلومات، يجعل الحديث بشكل استراتيجي عما يحدث في أوكرانيا وتبعاته الإقليمية على أوروبا وكذلك تبعاته العالمية، أمراً صعب المنال. فكيف يمكن اتخاذ الخطوات الأولى لترشيد الحوار عندنا حول ما يجري؟ بدايةً الحديث الراشد حول الغزو الروسي لأوكرانيا هو أن نحدد وحدات التحليل في المشهد الذي نحن بصدده، وكيف تُحدد تلك الوحدة السردية التي تحاول الأطراف المتصارعة تصديرها إلى العالم. فبينما يرى الأوروبيون ومعهم الولايات المتحدة الأميركية ما جرى من منظور السيادة الوطنية التي تمثل نواة القانون الدولي، ويكون بناءً عليها ما جرى خرقاً صارخاً لهذا القانون، نجد روسيا في المقابل ترى التحالفات وليست الدول هي وحدة التحليل التي يجب النظر إليها، وأن الحوار حول ضم أوكرانيا لحلف الناتو يمثل تهديداً مباشراً لروسيا يصل إلى غرفة نوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس مجرد تهديد للأمن القومي الروسي فقط. وبناءً على هذه الرؤية يكون ما اتخذه بوتين من إجراء تجاه أوكرانيا هو أمر مشروع لدرء الخطر. التنقل بين وحدتي التحليل (الدولة الوطنية ذات السيادة) و(التحالفات) في الأحاديث العربية المكتوبة والمتلفزة هو الذي يؤدي إلى حالة التخبط والضبابية في قراءتنا للمشهد في أوروبا.
أيضاً نحن لدينا استعجال في مسألة التنبؤ بالمستقبل، هل أوكرانيا بداية حرب عالمية ثالثة، أم أنها حرب باردة من نوع جديد؟ وحتى في حديثنا عن هذه المفردات أحياناً لا ندرك التغير النوعي الذي حدث. فلا عالم الحرب العالمية الثانية هو العالم ذاته، ولا عالم الحرب الباردة الثانية هو عالم الحرب الباردة الأولى.
فمثلاً نرى اليوم الحديث دائراً عن الخيار الاقتصادي الذي يتمثل في فصل روسيا تماماً عن نظام «سويفت» البنكي والذي يجمّدها تماماً عن حركة المال العالمية. هذا العالم المتشابك مالياً لم يكن موجوداً في الحرب العالمية الثانية، ولم يكن ضمن خيارات المواجهة في الحرب الباردة الأولى. هذا مجرد مثال عن الفروق النوعية في طبيعة عالمنا الجديد. عالم يمكن فيه أيضاً لتحالف المخربين السيبرانيين خارج إطار الدول أن يتخذ قراراً بتخريب النظام الروسي الإلكتروني من الداخل. إذن نحن هنا أمام تغير طبيعة اللاعبين في الصراعات الدولية؛ فمجموعة مثل تحالف أنونيموس (anonymous) والتي هي أشبه بتنظيم القاعدة الإلكتروني من دون آيديولوجيا، يمكن أن تمثل خطراً جاداً للنظام السيبراني العالمي. أعرض لهذين النموذجين المختلفين لتوضيح فكرة التغير النوعي في النظام العالمي الجديد لندرك طبيعة ما نتحدث عنه هنا. كما أدعو إلى التروي في التحليل، بمعنى أن حسم مسألة الكويت لم تكن بالسرعة التي نريدها لحسم الانسحاب الروسي من أوكرانيا، حيث استمر احتلال الكويت لمدة سبعة أشهر ونحن ما زلنا لم نتجاوز أسبوعاً في مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا ونستعجل الحلول. النقطة الثانية هي تغير طبيعة النظام العالمي بشكل نوعي وتغير طبيعة اللاعبين في هذا النظام الجديد.
حتى هذه اللحظة لم نتحدث عمّن المقصود في ردة الفعل الأوروبية – الأميركية، هل المقصود مَن هو خلف حزمة السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مضافاً إليه بريطانيا وأميركا، أم هل المقصود هو احتواء روسيا وحدها أم احتواء روسيا والصين معاً تحسباً لما قد تفعله الصين بتايوان تمثلاً بما فعلته روسيا بأوكرانيا؟ وهل مجموعة مثل الاتحاد الأوروبي متماسكة كما نتصور أم أن التشابك الاقتصادي العالمي قد سبب شرخاً بين ألمانيا (مركز الثقل الاقتصادي الأوروبي) وفرنسا التي تدّعي أنها العاصمة السياسية للاتحاد؟ واضح أن الموقف الألماني مختلف تماماً عن بقية الاتحاد الأوروبي، ويمكن القول إن الموقف الألماني منذ اعتداء روسيا على جورجيا في أغسطس (آب) 2008 هو الذي أوصلنا إلى هنا. فيوم العدوان الروسي على جورجيا كان رجال الأعمال الألمان وكذلك النخب السياسية يحتفلون في السفارة الروسية في ألمانيا بالتعاون الروسي – الألماني على المستويات الاقتصادية المتعددة، وآخرها خط الغاز الذي يتيح لألمانيا مصدراً رخيصاً جداً للطاقة. أقول هذه النقطة هنا حتى لا يترحم البعض على قيادة المستشارة أنجيلا ميركل للاتحاد الأوروبي، فميركل 2008، أو حتى لو كانت معنا اليوم، هي ليست مارغريت تاتشر يوم غزو صدام للكويت. النقطة هنا هي أن الموقف الأوروبي ليس موحداً، كما أنه ليس صلباً وتنقصه القيادة الحازمة، وهذا ربما سبب مهم من الأسباب التي جعلت بوتين يقْدم على خطوة غزو أوكرانيا من دون التوقف عند فكرة العواقب أو تبعات هذا الغزو.
إذا أخذنا في الاعتبار تلك الملاحظات التحذيرية التي أوردتُها، ترى هل سيتم تطوير الموقفين الأوروبي والأميركي خلال سبعة أشهر قادمة، كما كان الحال في غزو الكويت، لتلعب بريطانيا مثلاً دوراً ترشيدياً لتطوير الموقف الأميركي؟ هل يلعب التهديد المباشر الذي يمثله الاجتياح الروسي لمعمار الأمن الأوروبي (European Security Architecture) دوراً في التسريع باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مما نحن عليه الآن؟ وهل يمثل تدفق الملايين من النازحين من أوكرانيا إلى كل من بولندا ضغطاً على دول ذات اقتصاد هش، خصوصاً وقد رأينا كيف كان التخبط الأوروبي تجاه لاجئين بأعداد أقل قادمين من دول بعيدة مثل سوريا؟ أسئلة كثيرة يطرحها الغزو الروسي، تحتاج إلى عقول أكثر هدوءاً في تحليل تبعاتها الإقليمية والدولية، بعيداً عن مشهد مشجعي كرة القدم الذي يتسيّد المشهد كما أراه اليوم.
الشرق الأوسط
———————————

في استراتيجية التوريط الأميركي المزدوج: بوتين وأوكرانيا مثالاً/ وائل مرزا
كان اللون الأحمر يطغى على بورصة نيويورك ظهر الجمعة الفائت، 18 شباط / فبراير، مع الانهيار المستمر في سوق الأسهم الأميركية، الأكبر في العالم، بسبب ارتفاع التضخم أساساً، ولكن أيضاً مع التأثير النفسي السلبي المعتاد لاحتمال حصول أزمة جيوسياسية. وفجأةً، ظهر مؤشرٌ صاعدٌ باللون الأخضر لإحدى الشركات الأميركية. كان الأمر يتعلق بشركة الأسلحة الضخمة جنرال دايناميكس. وجاء صعود سهمها بعد خبرٍ مرَّ هامشياً يتمثل في إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومن وارسو، موافقة الولايات المتحدة على بيع بولندا 250 دبابة من طراز أبرامز الفتاكة التي تصنعها الشركة العتيدة .
عملياً. كان الحدث في حقيقته يؤكد الحالة القائمة في العالم راهناً: كل الطرق تؤدي إلى أوكرانيا.
لماذا أوكرانيا؟
لا يكاد يوجد ارتباطٌ أقوى من الارتباط التاريخي بين روسيا وأوكرانيا. فكتبُ التاريخ تذكر أن أول دولةٍ سلافية وُلِدت في العام 988م، في مدينة كييف تحديداً، وكان اسمُها، Kyivan Rus، يجمع بشكلٍ واضح بين اسمي الدولة الروسية وعاصمة أوكرانيا الحالية.
من هنا، ليس غريباً أن تتكرر إشارة فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إلى تلك اللحظة الفارقة في التاريخ، مع التعليق دائماً بنفس الجملة: «الروس والأوكرانيون شعبٌ واحد. إنهم وحدةٌ متكاملة». وبالتالي، لايبدو غريباً هوس بوتين بمنع أوكرانيا، حصراً عن غيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق، من الالتحاق النهائي بركب الغرب عبر عضوية حلف شمال الأطلسي، الناتو. تتأكد حساسية الخاصرة الأوكرانية حين نتذكر أن روسيا تغاضت عن انضمام جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا، إلى حلف الناتو قبلها بسنوات، وتحديداً عام 1999، علماً أن الدولتين الأخيرتين تملكان حدوداً مشتركة مع روسيا.
ما يُصبح مفهوماً في هذا السياق، بالمقابل، هو أن تُضحي أطلسةُ أوكرانيا هدفاً استرتيجياً للغرب، وللولايات المتحدة على وجه الخصوص. وأن تزداد حساسية تحقيق هذا الهدف مع وضوح ملامح الصراع الحقيقي القادم مع الصين، القوة الحقيقية الوحيدة في العالم التي تؤرق صانعي القرار في واشنطن على المدى البعيد. وذلك من خلال إحكام قوس الحصار الشمالي على الصين، الذي يُصبح ممكناً عبر عملية ضعضعة روسيا، التي تبدو مطلباً آن أوانه في نظر الولايات المتحدة. وهو الهدف الذي سيكون فعالاً من المدخل الأوكراني على وجه التحديد، وبسبب المُعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية المذكورة أعلاه.
روسيا في المنظور الأميركي
ليس خفياً في هذا الإطار أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى روسيا، منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، على أنها قوةٌ دوليةٌ عظمى. هذا طرحٌ بات مُتداولاً في دوائر التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة منذ رسوخ حقيقة سيطرة بوتين، شخصياً كديكتاتور فرد، على مفاصل القرار في روسيا. والأهم، بما ترتبَ على ذلك من تجميد عملية البلورة لكمونٍ استراتيجيٍ روسيٍ هائل كان يمكن جداً أن تتولد عنه قوةٌ دوليةٌ عظمى، في حال امتلكت النخبة السياسية الروسية الإرادة والقدرة على تحويل البلاد إلى دولة مؤسسات.
ولو أن الولايات المتحدة سعت بنفسها لتفكيك ذلك الكمون من داخل روسيا، لما استطاعت أن تصل إلى هدفها بنجاحٍ يماثل إنجاز بوتين نفسه حين أفلحَ تماماً في سحق عملية المأسسة بشكلٍ يشمل كل قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية في روسيا، وفي تحطيم أي طبقةٍ قيادية ضروريةٍ لاستمرار الدور الروسي، على مستوى الهياكل والأفراد كليهما، وفي تحويل البلاد فعلاً إلى ما هو أشبه بدولةٍ مافيوية بحتة. وتلك صيرورةٌ تاريخية تخصمُ كثيراً من احتمال أن يكون لأي بلد وزنٌ دوليٌ حقيقي يُعتدُّ به على المدى الطويل بفعل قوانين الاجتماع البشري. بغض النظر عن قدرة بوتين على المناكفة هنا وهناك، من خلال استخدام عوائد النفط والغاز.
بل إن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، صاحب عقيدة «القيادة من الخلف»، عبّر بصراحةٍ عن نظرة بلاده حين قال في مؤتمرٍ يتعلق بالأمن النووي في مدينة لاهاي عام 2014: «روسيا هي قوةٌ إقليمية تشكل تهديداً لبعض جيرانها المباشرين، وهذا لا يتأتى من الشعور بالقوة بل على العكس من شعورها بالضعف». باختصار، كان بوتين، ولايزال، من وجهة النظر الاستراتيجية الأميركية أشبه بزعيمٍ فوضوي يمارس دور «الفتوة» أو «القبضاي» لإثبات وجوده، وفي محاولةٍ يائسة لأن يؤخذ بالاعتبار كشخصيةٍ لها دورها المؤثر في الساحة العالمية. فهو يشتري الولاءات، ويحرك عملاءه في أرجاء العالم ليسمم معارضيه. يمارس البلطجة والابتزاز داخلياً وخارجياً، شخصيا ومن خلال اختراق شبكات الانترنت في العواصم الدولية. يلعب لعبة توزيع الأدوار ويستخدم الفاسدين ويستعمل التهديد والوعيد.
هكذا، ترتسم عملياً في العالم صورةٌ لبوتين كزعيم عصابات قوي أكثر منها صورةً لقائدٍ سياسيٍ مُحترم. والمفارقة أن الرؤية الاستراتيجية الأميركية كانت لاتُمانع في أن يحاصر بوتين نفسه، وبلاده معه، في هذا النمط من الممارسة السياسية. بل وتشجعه، بشكلٍ مباشر وغير مباشر، على الانغماس في هذا الدور.
أولوية المصالح الأميركية
لا يمكن، بطبيعة الحال، رؤية الصورة من تلك الزاوية إلا بالعودة إلى الفهم البراغماتي للسياسة، وخاصةً بتجليها الأميركي، الأكثر وضوحاً وبشاعةً في واقع السياسة الدولية. فالتحليل السياسي، العربي والغربي، الذي يرى في حشود بوتين على الحدود الأوكرانية، بل وفي إمكانية احتلالها بشكلٍ كامل، على أنه ضربةٌ لالولايات المتحدة، هذا التحليل يتعامل في جوهره مع السياسة على أنها تتضمن اعتبارات أخلاقية بدرجةٍ أو بأخرى. في حين أن هجوم بوتين على أوكرانيا هو أكثر ما تنتظره الولايات المتحدة اليوم، كخطوةٍ عمليةٍ متقدمة على طريق «تأديب» الولد الأزعر الروسي، بعد أن أصبح الوضع الدولي يتطلب تحقيق هذا الهدف. وبحيث يصبح ذلك مدخلاً لإنهاك روسيا عبر آليات القانون الدولي، وبمشروعيةٍ سياسية عالمية، قد تتضمن العقوبات الدولية والحصار، إلى غير ذلك من ممارسات معروفة في مثل هذه القضايا.
بوضوحٍ أكبر. لا مصلحة تعلو على، أو حتى توازي، المصلحة الأميركية حين يتعلق الأمر بالعلاقات الخارجية. هذا هو المستوى الأول والأعلى الذي يحكم كل قرارات المنظومة السياسة الأميركية، بمكوناتها العسكرية والأمنية. ثم تأتي كل درجات المصالح المشتركة الأخرى، التي يتم إدارة الأزمات المتعلقة بها بشكلٍ محسوب يستوعبُ تَبِعاتها على الشركاء من خلال التعويضات اللاحقة لهم، فضلاً عن تذكيرهم باختلاف موازين القوى حين يتعلق الأمر بالولايات المتحدة ونفوذها في العالم، وبضرورة القبول بهذا الأمر الواقع من ناحية. ومن ناحية ثانية، ضرورة التضحية الجزئية من قِبَلِهم في سبيل استمرارية التحالف الاستراتيجي القادر دائماً على تحقيق مصالح قادمة لهم، وربما حتى تعويض التضحيات السابقة.
من هنا، كانت الدلالات وفيرةً دائماً بأنه لن يهتز، عملياً، جفنٌ للإدارة الأميركية، في حال احتلال روسيا لأوكرانيا بالكامل، وتزامنِ ذلك مع سقوط آلاف الضحايا من العسكر والمدنيين الأوكرانيين. وهو ما يراه العالم عياناً هذه الأيام. هذا لايتضارب أبداً، بطبيعة الحال، مع حجم الضجيج السياسي والدبلوماسي والإعلامي الهائل الذي بدأ يصدر عن تلك الإدارة نفسها، بما فيه عقد اجتماعات لمجلس الأمن، واستصدار قرارات دولية تمتد على طيفٍ يبدأ بالإدانة المعنوية ولا ينتهي بفرض درجات متفاوتة من العقوبات، قد تصل لدرجة الحصار على روسيا. كل هذا تحت عناوين حق الدول في السيادة الذاتية، واحترام القوانين الدولية، وعدم جواز فرض أمر واقع إقليمي حساس بالقوة العسكرية!
بنفس الطريقة، لا تهتم الولايات المتحدة بالضرر الاقتصادي الذي سيصيب ألمانيا، وباقي الدول الأوروبية، في حال انقطاع الغاز الروسي. أو الصعوبات التي يمكن أن يعانيها حلفاء آخرون مع اختفاء صادرات القمح الأوكراني. إلى غير ذلك من تحديات يمكن أن تمس العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وفي كثيرٍ من المجالات. هذه مسائل تقع في خانة الأضرار الجانبية بالنسبة للولايات المتحدة، سيتم التعامل معها لاحقاً، ولن تؤثر الحسابات المُسبقة لإمكانية حصولها في قرارات الإدارة كما يعتقد بعض المحللين، حين يعتبرون تلك الإمكانية على أنه رادعٌ لالولايات المتحدة، وقبل ذلك، على أنها أوراق مهمة في يد بوتين.
استراتيجية التوريط: لماذا؟ وكيف؟
عوداً على بدء، وكشرطٍ رئيس للتفكير في الحدث الأوكراني الراهن من المنظور الوارد في هذا التحليل، يجب دائماً استحضار العصب الرئيس له، والمتمثل في الأهمية الاستراتيجية لاستكمال قوس الحصار الشمالي للصين، تزامناً مع العمل المستمر على بناء القوس الجنوبي والشرقي، من خلال تطوير التواجد الأميركي المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، فضلاً عن كوريا الجنوبية واليابان وتايوان والفلبين، وصولاً إلى تطوير شبكات التحالف العسكري التاريخي مع أستراليا ونيوزيلندا[8].
بهذا المدخل في النظر، يُمكن إبصارُ ملامح رؤيةٍ أميركية طويلة الأمد، وعلى مراحل، لتوريط روسيا فيما يمكن أن يصبح بؤرةً كبرى للرمال المتحركة في أوكرانيا.
تجدر الإشارة هنا إلى لبسٍ شائعٍ في تحليل السياسات الأميركية الخارجية يتمثل في الاعتقاد بأن قوتها تكمن في قدرتها، المبالغ في الحديث عنها غالباً، على صناعة الأحداث، وفي كثيرٍ من الأحيان بمنطق «المؤامرات» التي لايقف في وجهها شيءٌ بشري. لكن الوقائع تُظهر أن مكمن القوة الأكبر في سياسات الولايات المتحدة الخارجية يتجلى في قدرتها على استيعاب وتوظيف الأحداث التي تجري في معظم مناطق العالم. وهي أحداث تجري بانسجامٍ مع قوانين الاجتماع البشري، بمعنى أنها نتائجُ تنبني بشكلٍ منطقي على مقدمات معينة، ثم إن الحدث إما أن يمضي في اتجاهٍ أكثر عفويةً إذا كان لايحظى باهتمام قوىً إقليمية أو دولية، أو أن يصل إلى مفرقٍ يصبح فيه حساساً وبشكلٍ يؤثر في مصالح تلك القوى، مما يدفع بعضها على التدخل المباشر فيه بغرض توجيهه بما يخدم مصالحها.
يندرج في هذا ما تحدثنا عنه من قيام بوتين نفسه بتحويل بلاده إلى دولة مافيات، وإلى تجميد ثم قتل السياسة فيها بشكلٍ لم تكن تحتاج معه الولايات المتحدة سوى إلى «الفرجة». أما في أوكرانيا، فقد كان المسار «الطبيعي» الشعبي الغالب يميل إلى الاستقلال عن روسيا والتقارب مع أوروبا، وصولاً إلى لحظة توقيع اتفاق شراكة بين البلاد وبين الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2013. بالمقابل، لم يكن بوتين يملك سوى العمل بمنهجه في الممارسة السياسية الغارق في القناعة بمنطق قوة الفرد الديكتاتور، فضغط على الرئيس الأوكراني، وقتها، فيكتور يانوكوفيتش، الذي أوقف توقيع الاتفاقية قسراً. كان ذلك بمثابة الشرارة التي فجّرت ما يمكن النظر إليه على أنه الموجة الثانية من الثورة البرتقالية التي أسفرت عن هروبه من البلاد إلى روسيا حاصلاً على اللجوء السياسي، وسيطرة التوجه السياسي المؤيد للتقارب مع الغرب على مقاليد السلطة في كييف.
يُجدي في هذا السياق التذكير بأن الحدث المذكور كان استمراراً لما يمكن وصفه بالصراع الاستراتيجي الروسي الأميركي على أوكرانيا. سيما وأنه كان بمثابة تكرار للسيناريو الذي حصل قبلها بعشر سنوات، حين تصاعد دعم الولايات المتحدة وأوروبا لما سُمي بـ «الثورات الملونة» في جورجيا وأوكرانيا، لأهداف لا يمكن حصرها في البراءة الأخلاقية وفي دعم الشعوب لتقرير مصيرها. نتج عن الثورة البرتقالية الأوكرانية يومها فوز الرئيس المعادي لروسيا فيكتور يوشينكو في انتخابات عام 2005، رغم محاولة تسميمه الغامضة التي كادت تودي به إلى الموت وأدت إلى تشويه وجهه بشكل ملحوظ ودائم، والتي تمت خلال حملة الانتخابات، وشاع الاعتقاد القوي بأن روسيا كانت وراءها.
هكذا، أظهر العقدان الماضيان أن رهان بوتين كان دائماً على الأفراد الفاسدين من الساسة، في أوكرانيا وغيرها، وعلى نمطٍ في الممارسة السياسية تغلب عليه باستمرار عقلية المافيا بكل تجلياتها المعروفة. على المقلب الآخر، كانت الولايات المتحدة، وبمساعدةٍ أوروبية، تستوعب صيرورةً شعبية أوكرانية واسعة القبول في البلاد، وتوظفها بمهارة، وبمرحليةٍ وتدرّجٍ ونفسٍ طويل، لتحقيق هدفها الاستراتيجي. جرى هذا، كما يجري في كثيرٍ من مناطق العالم الأخرى، عبر خلق حالةٍ من «تقاطع المصالح» التي تبدو «عفويةً» بين توجهات الولايات المتحدة وقيمها المُعلنَة عالمياً، وبين طموحات الشعب الأوكراني المشروعة.
ثمة قراءتان لما حصل بعد ذلك في أوكرانيا، ولممارسات بوتين تجاهها، قد تبدوان متناقضتين للوهلة الأولى. لكن السياسة في منطقها المعاصر تحمل فسحةً للتعايش بينهما، وتساعد المحلل على امتلاك قوةٍ تفسيريةٍ أكبر للظاهرة. خاصةً في معرض الحديث عن غزو أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم (مقاطعة كرايميا) وضمها للاتحاد الروسي.
فمن ناحية، يمكن القول أن بوتين فهم دلالات أحداث ثورة عام 2014، وشعر بالحاجة الماسّة إلى تصرفٍ حاسم يمكن اعتباره رداً على الغرب، وخلقاً لأمرٍ واقع مختلف يعطيه مزيداً من الأوراق التفاوضية في المستقبل.
ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن القول بأن بوتين ابتلع الطُّعمَ الأميركي. بمعنى إفلاح الولايات المتحدة في دفعه للتورط بشكلٍ أكبر وأوضح فيما سيصبح المستنقع الأوكراني، وهذه المرة بالقوة العسكرية الروسية، وعلى مرأى ومسمعٍ من العالم ومنظماته الدولية.
كان بوتين يحسَبُ أنه امتلك «مسمار جحا» في البيت الأوكراني، وأن هذا سيجعله مؤهلاً دائماً للتدخل في شؤون البيت حين تدعو الحاجة لذلك.
وكانت الولايات المتحدة ترى أن خطوة التدخل العسكري الفاقعة بحد ذاتها أعطتها «مسمار جحا» الخاص بها، والذي سيسمح لها منذ تلك اللحظة بشَرعَنة كل أنواع الاستفزاز لروسيا والتحرش المتصاعد بها، وبكل المداخل القانونية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية.
وتصديقاً لما تحدثنا عنه سابقاً من غياب العامل الأخلاقي حين يتعلق الأمر بمصالح الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية، جاء موقف الإدارة الأميركية محصوراً في استنكار احتلال القرم، مع الحرص على استصدار المزيد من العقوبات الدولية التي ستساهم في محاصرة روسيا تدريجياً. وتزامن هذا مع تضييقٍ كبير على روسيا من المداخل المذكورة أعلاه، خلال عامي 2015 و2016. وربما نسي الكثيرون اليوم أجواء تلك المرحلة وحجم الضغط الذي كانت تشعر به روسيا إلى درجةٍ دفعتها إلى أن تعيش داخلياً ما هو أقرب إلى حالة إعلان الحرب. وشاع الحديث في الإعلام الروسي آنذاك عن «مخططات جنرالات الحرب وأصحاب الرؤوس الحامية» في واشنطن الذين يسعون إلى إشعال فتيل حربٍ عالميةٍ ثالثة.
فخلال النصف الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2016 بثت المحطة الإخبارية روسيا 24 تقريراً حول تحضير ملاجئ للحماية من ضربات نووية في موسكو. وتحدث موقعٌ إلكتروني واسع الانتشار في سان بطرسبرغ عن احتمال البدء بتقنين الخبز استعداداً لحرب مقبلة. وتزامن ذلك مع الإعلان عن تدريبات دفاع مدني تحشد 40 مليون متطوع على مدى أسبوع، يتدربون على إخلاء مبان ومواجهة حرائق. وانتشرت بشكلٍ ملحوظ تقارير تصدر عن مراكز بحثية روسية تعقد فيها مقارنات بين الموقف في تلك الأيام والوضع الدولي عشية اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية. كما أوقف بوتين فجأةً، بأوامر رئاسية، العمل باتفاقيتين مع الولايات المتحدة تتعلقان بالحد من أبحاث البلوتونيوم واليورانيوم والأسلحة النووية، إلى غير ذلك من الظواهر.
اشتعال الأزمة الراهنة
هدأ الاستفزاز الأميركي المباشر بعدها عندما انتُخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، رغم استمرار العقوبات التي كان الكونغرس بمجلسيه، وبأعضائه الجمهوريين والديمقراطيين، يحرصون على تجديدها وتطويرها. ثم عاد للتصاعد إلى أن بلغ ذروةً جديدة تمثلت في المناورات البحرية الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع أوكرانيا في شهر تموز/ يوليو الفائت، في البحر الأسود المتاخم للحدود الروسية. كان هذا تمريناً سنوياً يجري كل عام منذ سنة 1997، لكن حجم المناورات وطبيعتها لفتت هذه المرة انتباه الدوائر العسكرية والاستراتيجية في العالم. فقد شاركت فيها قوات مثلت 32 دولة من ستة قارات، وضمت خمسة آلاف مقاتل و32 سفينة حربية متنوعة الأحجام والمهمات، فضلاً عن 40 طائرة حربية و 8 فرق للعمليات الخاصة البحرية.
مرةً أخرى، استجاب بوتين للاستفزاز الأميركي وسرعان مابدأ بحشد عشرات الآلاف من الجنود حول الحدود الأوكرانية مع نهاية العام الماضي وبدايات هذا العام، بشكلٍ مثّلَ البداية العملية للأزمة الراهنة.
لم تكن الولايات المتحدة فقيرة الخيال إلى درجة أنها لم تتوقع رد الفعل الروسي الذي وصلَ إلى حد الاجتياح الفعلي منذ أيام، بل الأرجح أن تُثبت الوقائع أن رد الفعل ذاك يَدخل، بالضبط، فيما تريدهُ أن يحصل، وبحيث يكون عذراً لها في زيادة وترسيخ حضورها العسكري حول روسيا من كل جوانب الجبهة الروسية الغربية الأكثر حساسيةً على الإطلاق. هذا ما حصل عملياً، فخلال الأسابيع القليلة الماضية ضاعفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في بولندا، وأرسلت المزيد من الطائرات المقاتلة لتتمركز في قواعد جوية في أستونيا، ودفعت مقاتلاتها من طراز F-16s من ألمانيا لتتمركز في رومانيا، بينما قامت بتعويضها عبر نقل مقاتلات من قاعدة عسكرية في ولاية يوتا الأميركية إلى ألمانيا.
واستكمالاً لاستراتيجية التقدم والتوريط، تزامن الحراك العسكري الأميركي، للمفارقة، مع عمليات تمويه إعلامي ودبلوماسي وسياسي مدروسة، ولئيمة للغاية، دون أي اعتبار لاستفزازها النفسي الكبير لأوكرانيا شعباً وقيادة.
فعلى مسرح الأحداث هذا، يظهر بايدن شارحاً الفرق بين «الغزو الكامل» و«الغزو المحدود» الذي يمكن أن تقوم به روسيا، وكيف أن رد الفعل العسكري الأميركي سيختلف تبعاً لذلك الفرق، فيحرص الرئيس الأوكراني على التصريح بأنه لا يوجد ثمة شيء اسمه «غزوٌ محدود». تطالب أوكرانيا الولايات المتحدة بإعلان عقوبات على روسيا وقيادتها قبل الاجتياح لتكون فعالةً، لكن بايدن، ومعه وزير خارجيته، يصران على الاكتفاء بالتهديد بالعقوبات، والقول بأنها ستُعلن وستكون قويةً بعد حصول الاجتياح عملياً. يخرج بايدن على شاشات التلفزة خلال الأسبوع الماضي مرةً تلو أخرى ليؤكد حصول الاجتياح في الأيام القادمة، فيرد زيلينسكي مؤكداً بأن «إشاعة الخوف والذعر بتلك الطريقة هي أفضلُ صديقٍ للعدو». تُطالب أوكرانيا الولايات المتحدة بتزويدها بأسلحةٍ نوعية تُمكِّنها من التسبب بأذىً حقيقي لأي قوات اجتياح روسية، وتصر الولايات المتحدة على تزويدها بأنواع معينة أقل فعاليةً في تحقيق ذلك الهدف. وقد لايصدق البعض، ونحن نتذكر الوضع في سوريا منذ سنوات، أن أوكرانيا تستجدي حتى الآن مجرد إمدادها بصواريخ ستنغر الفعالة في مواجهة الطيران الروسي، ولكن دون جدوى!
لايبدو غريباً مع هذا الحال أن يخاطر الرئيس الأوكراني بمغادرة بلاده قبل الاجتياح بأيام لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، وإلقاء كلمةٍ خاطب فيها الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، بنبرةٍ غاضبة قائلاً: «ماذا تنتظرون؟ لانحتاج إلى عقوباتكم بعد أن يحصل القصف على بلادنا، وبعد أن نكون قد فقدنا حدودنا، وخسرنا اقتصادنا، ماذا تنفعنا العقوبات حينها؟».
هنا، يبدو فهم زيلينسكي المشروع للعقوبات، كسلاحٍ مُستَعجل يجب استخدامه فوراً لمنع الكارثة، بعيداً عن إدراك وظيفة العقوبات في ترسانة الفكر الاستراتيجي الأميركي كسلاحٍ نوعيٍ فريد لا يوجد له مثيل لدى دولة أخرى في العالم. وهي سلاح يُشهر في أي وقت، إما لإرسال رسائل أو لإحداث ضغط حقيقي، حسب كل حالة. أما وجودها فيهدف ليساعد الإدارة على استمرار العلاقات مع القوى الأخرى العالمية دون قطيعة كاملة، وبشكلٍ يبدو فيه انسجامٌ مع مبادئ الولايات المتحدة المُعلنة. هذا النوع من القوة الناعمة يثير الحيرة فيما يتعلق بأساليب الرد عليه لدى الدول التي تتعرض له، ويصيبها بالارتباك. فهو يُشعرها دائماً بالضعف تجاه الولايات المتحدة، لكنه لا يصل إلى درجةٍ تضطر فيها الدولة المعنية إلى مقاطعة الولايات المتحدة أو العداء معها. أما عندما يحتاج الأمر إلى مزيد من الحسم في نظر الإدارة الأميركية، فإن من الممكن دائماً التصعيد في استخدام العقوبات بشكلٍ يؤذي الدولة المعنية.
الاجتياح ودلالاته
تصاعدَ الاستفزاز لبوتين خلال الأسابيع التي سبقت اجتياح أوكرانيا بدرجةٍ غير مسبوقة. وأدارت الولايات المتحدة العملية بإخراجٍ مدروس يخاطب، تحديداً، مكونات شخصيته كزعيم مافيا معتد بنفسه، وكقبضاي لا يقبل الإهانة (ولو على قطع رأسه). لم يكن قد تغير شيءٌ في طبيعة الحشود الروسية حول أوكرانيا، والتي اكتملت بشكلٍ كبير منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. لكن آلة الدعاية السياسية والدبلوماسية والإعلامية الأميركية اشتعلت بالتصريحات اليومية التي حرصت على وضعه في «كماشةٍ» نفسية وسياسية.
وبدءاً من تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، اليوم الذي ظهر فيه مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين باسكي، لتفعيل عملية الاستفزاز في مرحلتها الأخيرة، تم صياغة الحملة الأميركية المذكورة بحيث تتمحور حول الرسائل التالية الموجهة له شخصياً: نحن نعرف تماماً كيف تفكر، أنت على وشك إعلان الحرب في أي لحظة، لدينا استخبارات موثوقة تتعلق بكيفية إخراجك لقرار الهجوم، سيحصل ذلك على شكل عمليات تخريبية زائفة تستهدف القوات الروسية، نحذرك من التهور والقيام بذلك لأن روسيا ستواجه رداً غير مسبوق، إلى غير ذلك من التصريحات التي تعرف الولايات المتحدة أنها ستصبح عنوناً رئيساً يتصدر كل نشر أخبار في العالم وكل صحيفةٍ دولية.
بهذا، وُضِع بوتين، بكل مافي شخصيته من قوة «الأنا» العنيدة أمام خيارين أحلاهما مرّ. فإما أن يكتفي فعلاً بعملية التهديد والتفاوض للحصول على أقصى ما يمكن، ويمتنع عن إشعال الحرب، فيبدو في نظر العالم متردداً وخائفاً من الولايات المتحدة. أو أن يتجاهل كل الحسابات العملية التي توحي بإمكانية انزلاق بلاده إلى المستنقع الأوكراني، فـ «يُظهِرَ» للعالم أنه «القيصر» الذي ينفخ في غروره جزءٌ كبير من الإعلام الدولي على مدى سنوات.
وفي استجابةٍ مثاليةٍ، فيما يبدو، للاستفزاز الأميركي، انخرط الرئيس الروسي في الحرب بطريقةٍ تدريجية، توحي بالتردد من جهة، وتسمح للولايات المتحدة بتوظيف مسار الأحداث من جهةٍ ثانية. أخرج بوتين قرار الحرب بالاعتراف الرسمي بالمقاطعتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، على أمل دفع قواته إليهما والاكتفاء بخلق أمرٍ واقع جديد، كما فعل قبل سنوات في شبه جزيرة القرم. حصل هذا في حين كانت الولايات المتحدة تخشى من اندفاعةٍ قويةٍ وشاملة للجيش الروسي تصل إلى احتلال كييف والسيطرة الكاملة والسريعة على أوكرانيا بما يحد من قدرتها على الحركة، ويضطرها لردود أفعال كبيرة لا ترغب بها حالياً. وهكذا، منحتها استراتيجية بوتين المترددة الفرصة لترتيب عملية استنزاف متدرج وطويل المدى لروسيا عسكرياً ودبلوماسياً.
سرعان ما بدأت مرحلة العقوبات لحظة دخول الجنود الروس إلى المقاطعتين. وسنرى كيف تتبلور وتتطور بشكلٍ انتقائيٍ ومدروس، ينسجم مع منطقها المذكور أعلاه في هذا التحليل. أوقفت ألمانيا الترخيص لمشروع نوردستريم 2 العملاق الذي كان يؤرق الولايات المتحدة إلى درجةٍ كبيرة، لأنه سيضع جزءاً كبيراً من أوروبا رهينةً للغاز الروسي في المستقبل. وفيما أسماه بايدن «الدفعة الأولى» من العقوبات، تم استهداف شخصيات مقربة من بوتين شخصياً وتمثل جزءاً من أركان حربه، فضلاً عن بنوك وشركات معينة تخدم بوتين، أيضاً شخصياً، ومعه آلته الاقتصادية والعسكرية، لكن الانتقاء تمَّ بحيث يشعر الطرف الروسي بدرجةٍ من الألم في جسده، يعرف معها الكمون الموجع الحقيقي الذي يمكن أن يحصل مع تصعيد العقوبات كمياً ونوعياً، فيكون هذا سبباً للمزيد من التوتر والارتباك.
ثمة وجهٌ آخر حساس للانتقائية في العقوبات يتمثل في صرف النظر عن كل مايمكن أن يتسبب بمزيدٍ من التضخم في الولايات المتحدة، حيث تمَّ بشكلٍ مُعبّر، مثلاً، استثناء صناعة الطاقة الروسية بأسرها، والتي تمثل عصب الاقتصاد الروسي، بما فيها مجهودها الحربي، من العقوبات حسب تقارير وزارة الخارجية الأميركية.كان هذا يهدف لمنع ارتفاع أسعار الطاقة التي تُنهك المستثمر الأميركي حالياً. والواضح أن سوق الأسهم الأميركية، بحساسيتها المُرهفة للأحداث العالمية، استوعبت دلالات الحدث فعادت للارتفاع بشكلٍ قياسي مع أول إعلانٍ للعقوبات في أول يومٍ للاجتياح، وأكملت الصعود في اليوم الثاني.
خاتمة
لا ينبع هذا التحليل من قناعةٍ اختزالية تفترض سيطرةً كونيةً مُطلقة للولايات المتحدة على ما يجري في العالم أو ماستفعله روسيا، وإنما يتعلق باستشراف طريقةٍ ومستوى من الفكر السياسي في الولايات المتحدة، فريدٍ من نوعه، يتعايش فيه التخطيط الاستراتيجي طويل المدى مع الأخطاء والخطايا التي كثيراً ما تحصل، وبالتناوب مع عمليات الاستدراك والاستيعاب والتوظيف، آنياً أو لاحقاً، للأخطاء نفسها، في كسب أوراق تكتيكية أو استراتيجية جديدة. والأهم أن كل نوعٍ من الأخلاقيات تغيب فيه، إلا عندما يتطلب الحال استعمالها بشكلٍ وظيفي، ويكون هذا بحد ذاته جزءاً من ذلك الفكر السياسي.
وإذ تتصاعد الأحداث مع كتابة هذه الكلمات، وتبدو المتغيرات أسرع من القدرة على مواكبتها فيما يتعلق بالتفاصيل المستجدة. لكن عناصر الصورة الاستراتيجية التي تمثل صُلب الفرضية الأساسية الواردة في التحليل تكتسبُ باضطراد شواهد إضافية.
القوات الروسية على أبواب العاصمة كييف. رغم هذا، تفعل الولايات المتحدة المستحيل بحيث لا تُمنى روسيا بوتين بهزيمةٍ سريعةٍ في ميدان العمليات. فالهدف الرئيس هو تورط روسيا قدر الإمكان عسكرياً في الداخل الأوكراني لأطول فترةٍ زمنيةٍ ممكنة، وبما يسمح بتصعيد العقوبات ومعها كل أنواع الاستنزاف، وتحديداً في الداخل الروسي. حين يصل تأثير الوضع الاقتصادي المتردي إلى عموم المواطنين، وتبدأ صيحات المعارضة الروسية في الظهور والازدياد، مع دعمٍ كبير، بطبيعة الحال، من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية لتوجهاتها الديمقراطية ومطالبها المُحقّة المتعلقة بالحرية ومحاربة الفساد والبحث عن لقمة العيش ودولة القانون! يصبُّ في ترسانة الولايات المتحدة هنا خزينٌ من الصبر الاستراتيجي الذي لا يدفعها إلى استعجال الأمور على الإطلاق. ذلك أن تطور الأحداث وفق مسارها الراهن يمثل أفضل سيناريو يمكن توظيفه لتحقيق هدفها الاستراتيجي: توريط روسيا وإنهاكها داخلياً تمهيداً لتحويلها، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، إلى الجزء الأخير والأكثر أهمية من قوس الحصار الشمالي للصين.
أما الآن، فالطائرات الروسية، ومعها الحوامات، تسيطر على أجواء أوكرانيا، وتساهم في التقدم الروسي بشكلٍ لافت. رغم ذلك، يغيب عن الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، الذي صمّت الولايات المتحدة أذن العالم بخصوصه، أجهزة دفاع جوي تتضمن صواريخ فعالة مضادة للطائرات والحوامات.
وفي حين يردد بايدن ومساعدوه بشكلٍ مملّ مقولة استعداد بلادهم للدفاع عن كل شبرٍ من أراضي دول الناتو، تبدو الرسالة فاقعةً للرئيس الروسي لإلغاء أي تخوفٍ يمكن أن يراوده من أي تدخل عسكري فعلي غربي في أوكرانيا.
وبينما يتداول الخبراء الاستراتيجيون جملة عقوبات اقتصادية يمكن أن تشلّ الدولة الروسية، وتجفف موارد الدعم للتواجد العسكري الروسي في أوكرانيا، وفي غضون أيام. لا تبدو الولايات المتحدة في وارد الاستعجال لإعلان ذلك النوع من العقوبات عل المدى المنظور. يكفي مثالاً على ذلك منع روسيا من استخدام نظام SWIFT المصرفي العالمي، الذي يُطلِق عليه مراقبون وصف «الخيار النووي»، بسبب تأثيره الخطير في إمكانية عزل روسيا، بكل مؤسساتها اقتصادياً عن العالم بأسره.
هذا نموذجٌ مثاليٌ آخر على توظيف الصراع المؤطَّر (Contained Conflict) الذي كثيراً ما تستعمله الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها داخل حدود بلدٍ معين، ومن خلال توريط قوةٍ أخرى خارجيةٍ فيه. هكذا، تغرق روسيا في الرمال المتحركة الأوكرانية، ويتم ضبط آثار الصراع العسكري بحيث لا يُسمح لها بالامتداد إقليمياً مع ما يمكن أن ينتج عنه من فوضى غير محسوبة ولا مضبوطة. وبالمقابل، تدفع أوكرانيا الثمن، ولكن في خضمّ تصريحات التضامن الدولي الإعلامية، وبعض الممارسات المتسقة معها، دون أن يكون لها تأثيرٌ فعلي في موازين القوى العسكرية. الأمر الذي تدرك الولايات المتحدة تأثيره المعنوي السلبي الكبير في صفوف الأوكرانيين قيادةً وشعباً!
المفارقة أن أكثر من يدرك اليوم هذه الحقائق هو الرئيس الأوكراني نفسه. وهذا مايُعبر عنه بشكلٍ مُعلَن يُظهر استياءه المتصاعد مما يراه عمليةَ نفاقٍ عالمية تشهدها بلاده. ففي تصريحاته صباح الجمعة، اليوم التالي لبدء الاجتياح الروسي، أكد زيلينسكي لمواطنيه أنه تواصل مع كل الدول الغربية طلباً للدعم، وأكد أنهم جميعاً «خائفون»، وأن بلاده تُركت لتقاتل وحدها. ومصداقاً لحالة اليأس التي يعيشها، مع أركان حكومته، ناشد الرجل بوتين داعياً إياه للسلام، متحدثاً عن الضحايا المدنيين ومذكراً بحياد أوكرانيا، فعرض عليه الكرملين مباحثات في مدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء الموالية كلياً لروسيا، بينما عرضت أوكرانيا التفاوض في عاصمة بولندا، وارسو.
ثمة احتمال قوي جداً بألا تسمح الولايات المتحدة، ابتداءً، باستمرار هذا التوجه الذي قد يُخرج الأمور من يدها، والراجح بأن تضغط الإدارة الأميركية على زيلينسكي لوضع شروط تعجيزية تمنع إمكانية انطلاق المسار. وسيتزامن مع هذا إعلان ترتيبات فيها درجات من الإيحاء لأوكرانيا بنية الدفاع الجدّي عنها، وبتصعيد العقوبات بشكلٍ يؤذي روسيا. والأهم، تقديم وعود مستقبلية تدخل في إطار الدبلوماسية السرية، يمكن أن تصل إلى حد التعهد باتخاذ الاجتياح الروسي ذريعةٍ لضمّ أوكرانيا إلى الناتو في أقرب وقت.
على مستوى تفاصيل الأحداث، يبقى الوضع مفتوحاً على كل الاحتمالات خلال الأسابيع، وربما الشهور، القليلة القادمة. لكن الصورة بأجملها لا تغير كثيراً في حقيقة وجود مكاسب استراتيجية أميركية تحصّلت من الأزمة الراهنة، على طريق تحقيق أهدافها البعيدة. قد لاتكون ثمة مفارقة في أن شركات الأسلحة الأميركية العملاقة، مثل ريثيون ولوكهيد مارتن أرسلت خطابات تفاؤل للمستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية تُبشرهم فيها بكمون زيادة الأرباح طرداً مع تزايد سوء الأوضاع في أوكرانيا. لكن المفارقة تتمثل في ألا ينتبه الكثيرون إلى مؤدى صراحة وزير الدفاع الأميركي نفسه حين أشار بوضوح إلى جوهر المكسب الاستراتيجي الأميركي، عندما قال في معرض الإعلان عن صفقة دبابات أبرامز لبولندا: «ما لم يكن السيد بوتين يريده هو وصول حلف ناتو أكثر قوةً إلى خاصرته، وهذا هو بالضبط ماحصل عليه اليوم».
موقع الجمهورية
———————————–
أميركا بين التحليل والعاطفة/ روبرت فورد
تنشأ السياسة الأميركية في التعامل مع أوكرانيا من الخلط بين التفكير التحليلي لدى خبراء الأمن القومي والعواطف لدى عامة المواطنين الأميركيين التي تؤثر على الساسة.
على الجانب التحليلى، كان الجدال قائماً بين الخبراء والمسؤولين حول ما إذا كان توسيع الناتو ليشمل الدول الشيوعية السابقة، مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا بعد الحرب الباردة، أثار الغزو الروسى لأوكرانيا، أم لا. وقد حُسمت هذه الحجة الآن في واشنطن. فالجانب الفائز يؤمن إيماناً راسخاً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديكتاتور يسعى لإعادة إحياء الإمبراطورية الروسية القديمة أو الاتحاد السوفياتي. وهم يُحذرون من أنه إذا لم يوقف العالم بوتين الآن، فإنه سيهاجم دولة أخرى مجدداً، على سبيل المثال دول البلطيق، فيسبب اندلاع حرب أكبر. لذا، أرسل بايدن مزيداً من القوات إلى أوروبا، فقد ارتفع عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في بلدان الناتو من 65 ألفاً في العام الماضي إلى أكثر من 90 ألفاً الآن. وضمن هذا الانتشار الأكبر، ضاعفت واشنطن عدد القوات الأميركية في بولندا إلى تسعة آلاف، وفي رومانيا إلى ألفين. ولا يوجد جدال هنا حول زيادة عدد القوات العسكرية الأميركية على الحدود مع أوكرانيا بالقرب من القوات الروسية.
ولم يطالب أي سياسي أميركي بدخول القوات الأميركية إلى أوكرانيا لقتال الروس، إذ يدرك الجميع المخاطر المترتبة على اندلاع حرب نووية. وهناك أيضاً فهم تحليلي من تجربة العراق في عهد صدام حسين، فضلاً عن إيران وسوريا، حيث إن العقوبات، حتى العقوبات الصارمة، ليس لها سوى تأثير محدود على الطغاة.
وهنا يأتي الجانب العاطفي لأميركا. الواقع، أن المشاهد المنتشرة على شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي للمدنيين والجنود الأوكرانيين، الذين يخوضون حرباً يائسة ضد عدو أكبر حجماً، تثير التعاطف الأميركي التقليدي مع الجانب الأضعف في أي معركة. فضلاً عن ذلك، فإن بعض المدن، مثل نيويورك وشيكاغو، تضم مجتمعات أوكرانية – أميركية ضخمة. وتنظم الكنائس في مدن كثيرة صلوات خصيصاً من أجل أوكرانيا. في ظل هذا المناخ العاطفي، فإن التعاطف الشعبي الأميركي مع أوكرانيا والغضب من موسكو يولد مطالب بأن تتخذ واشنطن مزيداً من الإجراءات. وسيكون الدفع الأكبر نحو مزيد من العقوبات. لقد فرض الاتحاد الأوروبي لتوه عقوبات على الأصول الشخصية للرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. لقد ترددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن التحرك الأوروبي ربما سيرغم بايدن على القيام بالشيء نفسه وفرض عقوبات أخرى أيضاً.
توصل الجانبان التحليلي والعاطفي في أميركا إلى استنتاج مفاده أن واشنطن لا ينبغي لها أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة، ولكن يتعين عليها بذل مزيد من الجهود لمعاقبة روسيا ومحاولة مساعدة أوكرانيا.
المراقب السياسي الجيد للسياسات الأميركية سيولي اهتماماً خاصاً لتطور موقف الحزب الجمهوري في الأسبوع الماضي. كان السيناتور الأميركي البارز جوش هاولي، الذي أظهر دعماً لهجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكونغرس، قال في وقت سابق من هذا العام، إن واشنطن يجب أن ترفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وفي يناير، قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي لديه طموحات سياسية كبيرة، إنه يكن احتراماً كبيراً لبوتين ووصفه بأنه «رجل دولة موهوب». وفي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أشاد الرئيس السابق دونالد ترمب ببوتين ووصفه بالزعيم القوي، وقال إنه رجل عبقري.
وبعد بدء الغزو وارتفاع المشاعر العامة، صار ترمب معزولاً. موقف الحزب الجمهوري العام يتحول إلى انتقاد بايدن لضعفه ومطالبته برد أكبر ضد روسيا. بومبيو، بالنظر إلى المناخ العاطفي هنا، غيّر لهجته يوم الخميس الماضي، وقال إن واشنطن يجب أن تفرض تكاليف أكبر على بوتين من أجل ردع مزيد من العدوان الروسي. ويحض جوش هاولي بايدن الآن على فرض عقوبات أكبر على روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة الروسي.
تجنبت إدارة بايدن حتى الآن، فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة. حتى الآن لا يتوقع قطاع الأعمال زيادة الإنتاج من الصخر الزيتي الأميركي، وبالتالي تتوقع الشركات أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة. واعترف بايدن للمرة الأولى يوم الخميس، بأن سعر البنزين للسائقين الأميركيين سيرتفع. كما أن الأزمة الأوكرانية ستعطل بعض صادرات الحبوب الأوكرانية والروسية وترفع أسعار الغذاء العالمية. وحتى قبل الأزمة الأوكرانية كان تضخم الأسعار في الاقتصاد الأميركي هو الأعلى خلال 40 عاماً، كما يمكن رؤية المخاوف حول ارتفاع التضخم في سوق الأسهم الأميركية. وقبل 40 عاماً، واستجابة لتضخم الأسعار، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى مرتفع للغاية، إلى 21 في المائة، حتى إنه تسبب في ركود اقتصادي رهيب (تخرجت من الجامعة وكان من الصعب جداً العثور على وظيفة) كان التوقيت آنذاك سيئاً بالنسبة لحملة إعادة انتخاب الرئيس كارتر. أشك في أن تصل أسعار الفائدة إلى 20 في المائة، ولكن يبدو أن التوقيت سيئ مرة أخرى بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي قبل 8 أشهر من الانتخابات المهمة للكونغرس.
الشرق الأوسط
——————————
في أوكرانيا، اتجاه التاريخ البشري على المحك
ترجمة عصام دمشقي
في قلب الأزمة الأوكرانية يكمن سؤال أساسي حول طبيعة التاريخ وطبيعة البشرية: هل التغيير ممكن؟ هل يمكن للإنسان أن يغير سلوكه، أم أن التاريخ محكوم عليه أن يعيد نفسه إلى ما لا نهاية، والإنسانية محكوم عليها إلى الأبد بإعادة مآسي الماضي دون تغيير أي شيء باستثناء الديكور؟
تنكر إحدى المدارس الفكرية بشدة أننا قادرون على التغيير. تجادل بأن العالم غابة، حيث يتغذى القوي على الضعيف، وأن القوة العسكرية هي الشيء الوحيد الذي يمنع بلداً من ابتلاع بلد آخر. كانت الحال هكذا دائماً وستظل دائماً كذلك. أولئك الذين لا يؤمنون بقانون الغاب لا يخدعون أنفسهم فحسب، بل يعرضون وجودهم ذاته للخطر، وهم لن يعيشوا طويلاً.
تؤكد مدرسة فكرية أخرى أن ما يسمى بقانون الغاب ليس سوى قانون الطبيعة. الإنسان هو الذي اخترعه، ويمكنه أيضًا تعديله. على عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة، فإن أول دليل أثري لا جدال فيه على وجود نشاط حربي منظم يعود إلى 13000 عام فقط. حتى أنه بعد هذا التاريخ، من الصعب العثور على آثار أثرية للحرب لفترات طويلة. على عكس ظاهرة الجاذبية، فإن الحرب ليست قوة أساسية من قوى الطبيعة. فشدتها ووجودها تعتمدان على العوامل التكنولوجية والاقتصادية والثقافية الأساسية. عندما تتغير هذه العوامل، تتغير الحرب.
المعرفة المصدر الرئيسي للثروة
نحن محاطون بعدة براهين على حدوث هذا التغيير. ففي غضون بضعة أجيال، حولت الأسلحة النووية حرب القوى العظمى إلى خطر مجنون للانتحار الجماعي، مما أجبر أقوى دول العالم على إيجاد وسائل أقل عنفًا لحل الصراع. وفي حين أن الحروب بين القوى العظمى، مثل الحرب البونيقية الثانية أو الحرب العالمية الثانية، كانت سمة سائدة في فترة طويلة من التاريخ، فإن السنوات السبعين الماضية لم تشهد أي صراع مباشر بين القوى العظمى.
خلال نفس الفترة، تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد قائم على السلع الأساسية إلى قائم على المعرفة. وفي حين كانت المصادر الرئيسية للثروة، ذات يوم، هي الأصول المادية مثل مناجم الذهب وحقول القمح وآبار النفط، فإن المصدر الرئيسي للثروة في الوقت الحاضر هو المعرفة. هكذا إذا كان من الممكن الاستيلاء على حقول النفط بالقوة، فليس الأمر نفسه بالنسبة للمعرفة. لذلك فإن الغزو الآن أقل ربحية.
أخيراً، شهدت الثقافة العالمية تحولًا جذريًا،عبر التاريخ، نظر العديد من النخب – رؤساء الهون، والفايكنج جارلز، والنبلاء الرومان، على سبيل المثال – إلى الحرب من منظور إيجابي. من سرجون الكبير إلى بينيتو موسوليني، سعى الحكام إلى تحقيق الخلود من خلال الغزو (والذي من خلاله طلب فنانون مثل هومر وشكسبير شيئًا أفضل من التملق). النخب الأخرى، مثل الكنيسة المسيحية، رأت الحرب على أنها شر لا مفر منه.
ومع ذلك، في الأجيال الأخيرة، وجد العالم نفسه لأول مرة محكومًا من قبل النخب التي تعتقد أن الحرب شر يمكن تجنبه. حتى جورج دبليو بوش ودونالد ترامب الآخر، ناهيك عن ميركلز وأردرنز في العالم ، هم سياسيون مختلفون تماماً عن أتيلا الهون أو ألاريك القوطي. يصلون إلى السلطة بشكل عام من خلال التعلق بحلم الإصلاحات الوطنية بدلاً من الفتوحات الأجنبية. في حين أن العديد من منارات الفن والفكر – من بابلو بيكاسو إلى ستانلي كوبريك – تشتهر بتصوير الرعب الذي لا معنى له للقتال بدلاً من تمجيد معماريها.
بارود المدافع أقل فتكاً من السكر
نتيجةً لكل هذه التغييرات، توقفت معظم الحكومات عن اعتبار الحروب العدوانية كأداة ممكنة للدفاع عن مصالحها، وتوقفت معظم الدول عن تخيل غزو وضم جيرانها. ببساطة، من الخطأ الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي الوحيدة التي تمنع البرازيل من غزو أوروغواي أو إسبانيا من غزو المغرب.
لا تنقصنا الإحصائيات التي تظهر تراجع الحرب. منذ عام 1945، أصبح من النادر نسبيًا إعادة ترسيم الحدود الدولية عن طريق الغزو الأجنبي، ولم يتم محو أي دولة معترف بها من قبل المجتمع الدولي، تماماً، من الخريطة من خلال الغزو الخارجي. كان هناك العديد من أنواع النزاعات الأخرى، مثل الحروب الأهلية وحركات التمرد. حتى مع أخذها جميعًا في الاعتبار، خلال العشرين عاماً الأولى من القرن الحادي و العشرين، فقد تسبب العنف البشري في وفيات أقل مما سببه الانتحار أو حوادث المرور أو الأمراض المرتبطة بالسمنة. البارود اليوم أقل فتكاً من السكر.
دقة هذه الأرقام موضع نقاش بين الجامعيين، لكن الجوهري أن نذهب أبعد من ذلك، فقد كان تراجع الحرب ظاهرة نفسية بالإضافة إلى كونها إحصائية. قبل كل شيء، كان له تأثير تغيير هائل في معنى كلمة “سلام”. عبر التاريخ، كان السلام مرادفًا فقط لـ “الغياب المؤقت للحرب”. في عام 1913، عندما قال الناس إن هناك سلامًا بين فرنسا وألمانيا، قصدوا أن الجيشين الفرنسي والألماني لا يواجهان بعضهما البعض بشكل مباشر، لكن الجميع كان يعلم أن الحرب بينهما يمكن أن تنفجر في أي وقت.
على مدى العقود القليلة الماضية، أصبح “السلام” يأخذ معنى “عدم معقولية الحرب”. العديد من البلدان اليوم لا تتصور أنه يمكن غزوها واحتلالها بسهولة من قبل جيرانها. أعيش في الشرق الأوسط، لذلك أعلم جيدًا أن هناك استثناءات لهذا الاتجاه. لكن تحديد الاتجاهات لا يقل أهمية عن القدرة على الإشارة إلى الاستثناءات.
عندما يتخذ الإنسان خيارات أفضل
“السلام الجديد” ليس شذوذًا إحصائياً أو وهم “الهيبيز”. الميزانيات المحسوبة بشكل بارد هي أوضح دليل على ذلك. في العقود الأخيرة، شعرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالأمان الكافي لإنفاق 6.5٪ فقط كنسبة من ميزانيتها على قواتها المسلحة، وإنفاق المزيد على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ما يمكن أن نأخذه بسهولة كأمر مسلم به، في حين أنه حداثة لا تصدق في تاريخ البشرية. لآلاف السنين، كان الإنفاق العسكري هو العنصر الأكبر في ميزانية الأمراء والخانات والسلاطين والأباطرة فهم نادراً ما كانوا ينفقون المال على التعليم أو الرعاية الطبية للناس.
إن تراجع الحرب ليس نتيجة معجزة إلهية أو تغيير في قوانين الطبيعة. وهو قد حدث لأن الإنسان اتخذ خيارات أفضل. يمكن القول إن هذا هو أعظم إنجاز سياسي وأخلاقي للحضارة الحديثة. و لسوء الحظ، إذا كان هذا الاتجاه قد ولد من اختيار الإنسان، فهذا يعني أيضًا أنه قابل للعكس.
تستمر التقنيات والاقتصادات والثقافات في التطور. إن صعود الأسلحة السيبرانية، والاقتصادات التي يحركها الذكاء الاصطناعي، وإعادة عسكرة ثقافاتنا، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى حقبة جديدة من الحرب، أسوأ بكثير من أي شيء رأيناه من قبل. للتمتع بالسلام، من الضروري أن يتخذ الجميع، أو الجميع تقريبًا، خيارات جيدة. في المقابل لا يتطلب الأمر سوى خيار واحد سيئ من جانب مشارك واحد لإشعال الحرب.
لذلك فإن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا يجب أن يقلق الجميع على هذا الكوكب. إذا تمكنت الدول القوية من سحق جيرانها الأضعف مع الإفلات من العقاب، فسوف تتغير المشاعر والسلوكيات في جميع أنحاء العالم. ستكون النتيجة الأولى، وربما الأكثر وضوحاً، لهذه العودة إلى قانون الغابة، زيادة حادة في الإنفاق العسكري على حساب الباقي. الأموال التي يجب أن تذهب للمعلمين والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين سيتم استثمارها في الدبابات والصواريخ والأسلحة السيبرانية.
حلقة مفرغة تؤدي إلى انقراض جنسنا البشري
إن العودة إلى قانون الغابة من شأنه أيضًا أن يقوض التعاون العالمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنع تغير المناخ أو تنظيم التقنيات التي يحتمل أن تكون خطرة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية. ليس من السهل العمل جنباً إلى جنب مع البلدان التي تستعد لمحوك عن الخريطة. و مع تسارع تغير المناخ والتنافس على الذكاء الاصطناعي، فإن خطر الصراع المسلح هو الذي يمكن أن ينمو، ويحبسنا في حلقة مفرغة يمكن أن تحكم على جنسنا بالانقراض.
إذا كنت تعتقد أن التغيير التاريخي مستحيل وأن البشرية لم تترك الغابة أبدًا ولن تتركها أبداً، فإن عليك الاختيار بين لعب دور المفترس أو الفريسة. و إذا أعطي القادة الاختيار، فإن معظمهم يفضلون أن يسجلوا في التاريخ بوصفهم مفترسين ويضيفون أسمائهم إلى قائمة الغزاة القاتمة التي يجب على الطلاب الفقراء حفظها في اختبارات التاريخ.
لكن هل التغيير ممكن؟ هل شريعة الغاب اختيار وليست قدراً؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الحاكم الذي يختار غزو جاره سيحتل مكانة خاصة في ذاكرة الإنسانية، أسوأ بكثير من تيمورلنك. سوف يذكره التاريخ باعتباره الرجل الذي أبطل أعظم إنجاز لنا. وسيعيدنا إلى الغابة عندما اعتقدنا أننا خرجنا منها.
الأوكرانيون لديهم أشياء ليعلمونا إياها
لا أعرف ماذا سيحدث في أوكرانيا. لكنني كمؤرخ أؤمن بإمكانية التغيير. هذه ليست سذاجة، لكنها واقعية. الثابت الوحيد في تاريخ البشرية هو التغيير. وحول هذا الموضوع، قد يكون لدى الأوكرانيين ما يعلمونا إياه. لم تعرف أجيال عديدة من الأوكرانيين سوى الاستبداد والعنف. لقد تحملوا قرنين من الحكم المطلق القيصري (الذي انهار أخيرًا وسط كارثة الحرب العالمية الأولى). وسرعان ما تم سحق محاولتهم القصيرة للاستقلال من قبل الجيش الأحمر، الذي أعاد الحكم الروسي. عاش الأوكرانيون بعد ذلك مجاعة رهيبة من صنع الإنسان مثل المجاعة الكبرى والإرهاب الستاليني والاحتلال النازي وعقود من سحق الديكتاتورية الشيوعية. عندما انهار الاتحاد السوفيتي، كان هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الأوكرانيين سيتبعون مرة أخرى طريق الاستبداد الوحشي- لأن هذا كان كل ما يعرفونه.
لكنهم اتخذوا خيارًا مختلفًا. على الرغم من ثقل التاريخ، وعلى الرغم من فقرهم المدقع وعلى الرغم من العقبات التي تبدو أنها لا يمكن التغلب عليها، فقد أسس الأوكرانيون الديمقراطية. في أوكرانيا، على عكس روسيا وبيلاروسيا، وصل مرشحو المعارضة إلى السلطة في عدة مرات. في مواجهة خطر الانجراف الاستبدادي، في عامي 2004 و 2013، ثار الأوكرانيون مرتين للدفاع عن حريتهم. ديمقراطيتهم جديدة تمامًا، تمامًا مثل هذا “السلام الجديد”. كلاهما هش وقد لا يدوم طويلاً. لكن الديمقراطية والسلام ممكنان ويمكنهما ترسيخ جذورهما بعمق. دعونا لا ننسى أن القديم كان جديدًا في يوم من الأيام وكل ذلك يعود إلى اختيارات الإنسان.
Yuval Noah Harari
ترجمه عن الفرنسية: عصام دمشقي
المقال مترجم إلى الفرنسية من قبلCourrier international.
تصفّح المقالات
———————————-
هل توقف أوكرانيا جنوج بوتين الجنوني في سوريا؟/ العقيد عبد الجبار العكيدي
ربما كان تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2015، تاريخ التدخل العسكري الروسي في سوريا، مفصلاً حاسما ليس على القضية السورية فحسب وإنما على السياسة الروسية حيال الغرب عموما والولايات المتحدة على وجه الخصوص، ذلك أن التفويض الذي منحه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستفراد بالملف السوري واستباحة الجغرافيا السورية، كان له كبير الأثر في تعزيز القناعة لدى بوتين بأن هشاشة الموقف الأميركي يجب استثماره جيداً، وقد مهد لهذه الهشاشة موقف الإدارة الأميركية ذاتها من استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين، فالصفقة التي جرت بين بوتين وأوباما في آب/أوغسطس عام 2013، ربما فاجأت الرئيس الروسي، لجهة سلاسة وليونة الموقف الأميركي.
الخطاب الدولي العام الآن حول الصراع في أوكرانيا بات يستحضر جرائم بوتين في الشيشان وحلب كنموذجين مأساويين لما يمكن أن يعانيه الشعب الاوكراني في حال انتصار بوتين، وهذا له دلالة على عدالة القضية السورية، ويدحض كل الأكاذيب والذرائع الروسية حول محاربة الإرهاب، ويعيدنا بالذاكرة إلى مقال نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية في شباط/فبراير 2016، إبان العدوان الروسي الغاشم على مدينة حلب قالت فيه: “إذا سقطت حلب فإن الحرب الشرسة في سوريا ستأخذ منعطفاً جديداً تماماً، فسقوطها سيؤدي إلى عواقب سيئة بعيدة المدى، لن تنعكس فقط على المنطقة، بل على أوربا أيضاً”، منذ ذلك الحين لم تعد استباحة الدم السوري من جانب الروس تثير أي إشكالية بالنسبة إلى الإدارة الأميركية والغرب عموماً.
طموحات الروس لم تكن تنظر إلى سوريا على أنها بؤرة مصالح اقتصادية وعسكرية فحسب، بل مساحة جديدة يمكن لبوتين أن ينطلق منها لمواجهة الغرب، فالروس يتطلعون إلى دور أكبر من سوريا، وربما ما يجمع بين المسالتين السورية والأوكرانية بالنسبة إلى روسيا هو أن المنطقتين تُعتبران ساحة صراع يمكن الانطلاق منها لمواجهة خصم أكبر، ذلك أن مواجهة هذا الخصم (أميركا) تستدعي بالضرورة وفقاً للروس إيجاد مناطق نفوذ واسعة في العالم توازي طوح بوتين الذي لا يرمي للارتقاء بروسيا الاتحادية كدولة ذات نفوذ قوي في المنطقة فحسب، بل ربما بات طموحه يسترد من مخيلته كل الصور الموروثة عن الإمبراطورية الروسية السابقة (الاتحاد السوفياتي).
الغزو الروسي لأوكرانيا، أدى إلى خلط الأوراق في المشهد الدولي ودخول العلاقات الدولية في أزمة سياسية مع روسيا، سيكون لها تأثير كبير على إعادة فرز المواقف والتحالفات الإقليمية والدولية، ولا شك أنه سيكون لها تداعيات على القضية السورية من جوانب عديدة أهمها:
أولاً، أن تطورات الحدث الاوكراني وما سيؤدي اليه الغزو الروسي سواء من حيث نجاحه في تحقيق أهدافه أو حال فشله، سيكون له ارتدادات كبيرة على الدور الروسي في سوريا، بمعنى أن نجاح الروس في فرض واقع جديد في أوكرانيا وشرق أوروبا سيمنحهم المزيد من أوراق القوة المتعلقة بسياساتهم الحالية والمستقبلية تجاه سوريا، بالمقابل فإنه في حال فشل روسيا وإخفاقها في مواجهة الدول الرافضة لتدخلها في أوكرانيا أو محاصرتها بحزمة العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها سيؤدي ذلك إلى ضعف قوة تأثيرها في الورقة السورية.
ثانياً، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والمتغيرات الدولية والإقليمية التي ستنجم عنه سنرى متغيرات ذات صلة بالوضع السوري بحكم اختلاف مواقف الفاعلين الدوليين والإقليميين المعنيين بالملف السوري تجاه هذا الغزو، وهذا يضعنا أمام تساؤلات جديدة حول مدى استمرار التفاهمات الروسية التركية من جهة، والتفاهمات الأميركية الروسية الإسرائيلية من جهة أخرى.
ثالثاً، يكشف الصراع القائم الآن بين روسيا والغرب عن إمكانية تبلور فرضيات جديدة سيكون لها تأثيرات مباشرة على علاقة هذه الأطراف بالملف السوري وبالعملية السياسية التي تشكل روسيا أحد مفاتيحها الأساسية، ولذلك علينا توقع عدة سيناريوهات في هذا السياق:
– استمرار استعصاء العملية السياسية وممانعة الدور الروسي الضاغط لإنجاز حل سياسي يحقق مصالح روسيا ويُبقي على نظام الأسد، وهذا السيناريو سيتوقف على كيفية تعامل الغرب مع الحدث الأوكراني، فكلما كانت المواقف حازمة وصلبة تجاه روسيا فإن هذا يمكن أن يكون عامل إضعاف للدور الروسي في سوريا.
– السيناريو الآخر، الوصول إلى تفاهمات وتسويات جديدة مع روسيا يكون ثمنها إطلاق اليد الروسية في سوريا مقابل ضبط الدور الروسي في شرق أوروبا والبلقان.
وبالعودة إلى السؤال المحوري الذي لا يفارق أذهان السوريين: هل سيكون لما يجري في أوكرانيا ارتدادات مباشرة على القضية السورية؟
يمكن التأكيد على أن مسعى الروس في سوريا وأوكرانيا قد يتقاطع في جانب مهم وهو أن المسالتين بالنسبة إلى روسيا هي جولة من معركة طويلة مع الغرب وتعتبر فصلاً من فصول الصراع معه وليس الصراع كله، ومن هنا يمكن التساؤل هل بمقدور الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا إجبار روسيا على إعادة النظر باستراتيجيتها في هاتين المسألتين؟ وهل ستنجح واشنطن في تقويض الطموح البوتيني في استعادة امجاد القوة السوفياتية. وهذا بالطبع يتوقف على استراتيجية الردع لدى واشنطن وحلفائها الغربيين.
بالنظر إلى المعطيات الراهنة وكذلك بالاستناد إلى المواقف المعلنة لكل العواصم الغربية يتبين أن كل أساليب الردع المزمع اتخاذها ضد بوتين لا تتجاوز العقوبات الاقتصادية بشتى أشكالها، مع التأكيد على استبعاد الجانب العسكري في مواجهة روسيا، ولكن اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا قد وضع العالم الغربي بمجمله أمام امتحان استراتيجي، ربما يجعله أمام خيارات وتحديات أخرى في حال لم يجد جدوى ملموسة لهذه العقوبات، ربما تكون الأرض السورية أحد هذه الخيارات، وساحة مناسبة للجم التمرد الروسي، ومجالاً لمواجهة غربية له من جديد، حيث أن إمكانية هذه المواجهة ما تزال متاحة إذا ارادت واشنطن استثمارها وعلى أكثر من مستوى.
فعلى المستوى العسكري، الأمر لا يحتاج سوى إعادة الدعم لفصائل الجيش الحر وتزويده ببعض الأسلحة النوعية المضادة للطيران (ستنغر)، والدروع (تاو)، والطائرات المسيرة، وصواريخ غراد، لإمطار قاعدة حميميم التي تعتبر نقطة ضعف أكثر منها قوة، والواقعة ضمن المدى المجدي لمدفعية وصواريخ الجيش الحر، ما يساعد على ذلك جغرافية المنطقة وتضاريسها الجبلية التي تسهل عملية الوصول اليها.
وعلى مستوى النفوذ الجغرافي، فان واشنطن تضع يدها على بقع من الجغرافيا السورية تعتبر الأغنى اقتصاديا بل هي غلة الاقتصاد السوري، فهي تسيطر على النفط والمياه والسلة الغذائية.
وعلى الصعيد الإقليمي، بإمكان واشنطن تمتين أواصر علاقاتها مع أنقرة التي لها مناطق نفوذ واسعة في الشمال السوري، وتعزيز علاقاتهما التقليدية وابعادها عن الابتزاز الروسي.
وعلى الصعيد السياسي، يمكن للولايات المتحدة وحليفها التركي أن تمارس تأثيراً كبيراً على كيانات المعارضة السورية السياسية والعسكرية ونسف كل ما بناه الروس سواء على مسار أستانة وسوتشي، أو مسار اللجنة الدستورية، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة إن أرادت أن تجعل روسيا هي المحاصرة في سوريا، وأن تجعلها تعيد التفكير جدياً بكيفية الخروج من المستنقع السوري.
اليوم وبعد أن دمر الدب الروسي سوريا، وغضّ العالم الطرف عن جرائمه التي راح ضحيتها عشرات الآلاف وملايين المهجرين والنازحين، ها هو المجتمع الدولي يدفع ثمن صمته وتواطؤ البعض منه مع روسيا، ولو كان هناك موقف دولي حازم من تدخله في سوريا لما تجرأ بوتين على مجرد التفكير بغزو أوكرانيا.
ولعل الأزمة الأوكرانية الراهنة تثير في أذهان الإدارة الأميركية نزعة نحو مراجعة مواقفها السابقة وخصوصاً بما يتعلق بالمسالة السورية، لتعيد السؤال: هل النأي عن القضية السورية كان صائباً؟ ألم يكن إفساح المجال لبوتين ليجعل من الأرض السورية ميداناً لتجريب صناعاته الحربية وتدريب عشرات الالاف من جنوده وطياريه، في قتل الشعب السوري، خطأً استراتيجياً فادحاً، أدى الى جموح بوتين الجنوني؟
المدن
————————-
أُسدِل الستار الحديدي على روسيا وبوتين بلا استراتيجية خروج من الورطة/ راغدة درغام
بين أكبر أخطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه دخل حرباً من دون “استراتيجية خروج” منها، وأنه أساء التقدير والحسابات لردود فعل الرئيس الأميركي جو بايدن والقيادات الأوروبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضرب محاولات ردعه عن غزو أوكرانيا بعرض الحائط، وأسقط روسيا في مشروع حرب استنزاف للقوات الروسية في أوكرانيا ستكون أكثر كلفةً لروسيا من مغامراتها عند غزوها أفغانستان، ما أدّى للعدّ العكسي لنهاية الاتحاد السوفياتي.
السيد بوتين يبدو اليوم طاووساً مزهواً بنفش ريشه، يجرؤ على تهديد القيادات الغربية بحرب عالمية إذا حاولت إيقاف زحفه على أوكرانيا. واقع الأمر أن بوتين أغرق نفسه في مأزق أوكرانيا ولن يستطيع التراجع، ليس فقط لأنه لا يحسن لغة التراجع، بل لأن العقوبات الغربية بدأت نهش الاقتصاد الروسي قبل أن ينتهي فلاديمير بوتين من نهش أوكرانيا. ففات الأوان. الخطر يحدق بالعالم وبروسيا وببوتين نفسه، لكن لفلاديمير بوتين قراءة مختلفة. مشكلته ستبدأ بعد إتمام العمليات العسكرية مطلع الأسبوع المقبل، وعنوانها أن بوتين يفتقد استراتيجية خروج وكذلك استراتيجية بقاء.
واضح أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن تخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا لإيقاف الغزو الذي أمر به فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وهذا ما راهن عليه سيد الكرملين عندما قرّر سحق البنية التحتية العسكرية، وتحويل أوكرانيا دولة منزوعة السلاح.
لم يكتفِ بوتين بمنطقة دونباس وكل الجمهوريات المنفصلة لضمان توسيع حدودها عبر العملية العسكرية الروسية، بل جهّز القوات الروسية لتلعب دور “إنقاذ السلام” هناك، وليس “حفظ السلام” في حال التوصّل لاحقاً الى تسوية سياسية. ذلك أن تعريف “إنقاذ” السلام يتطلّب من القوات الروسية الاحتفاط بأسلحتها الثقيلة وكامل ترسانتها، فيما “حفظ” السلام يقتضي أسلحة خفيفة لا تتناسق مع ما في ذهن الرئيس الروسي. وفي ذهنه أكثر من شرق أوكرانيا.
لا نعرف بعد كامل مشروع بوتين داخل أوكرانيا وفي مواجهة حلف الناتو، لكن نطاق العمليات العسكرية أفاد بأن في بال بوتين تطويق الداخل الأوكراني ومنعه من الوصول الى البحر الأسود عبر بوابة أوديسا القريبة من القرم، والتي يبدو مقبلاً على السيطرة عليها. هذا الى جانب تطويق العاصمة كييف انطلاقاً من روسيا البيضاء، بيلاروسيا، بما يؤدي الى إسقاط النظام هناك واستبدال نظام موال لروسيا به على نسق ذلك الذي في بيلاروسيا الآن.
هكذا يكتمل مشهد استرجاع العظمة الروسية والعظمة السوفياتية التي يحلم بها الرئيس الروسي، ويجلس بوتين الى طاولة المفاوضات مع الناتو بأوراق جديدة للتفاوض على الضمانات الأمنية التي طلبها من الولايات المتحدة والناتو، ولاقت استهتاراً غربياً فجّر انتقام بوتين وفعّل مشاريع غزوه أوكرانيا لإيقاف الغرب عن مسيرة توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي، بما يهدّد الأمن القومي الروسي، بحسب تفكير فلاديمير بوتين ومؤسسته العسكرية.
فغطرسة الرجل وعنجهيته تعرّضتا، في رأيه، الى إهانة ووقاحة الغرب، فقرّر نسف النظام العالمي برمّته لإعادة خلط الأوراق والمساومات على ترتيبات جديدة لنظام دولي جديد.
العقوبات الغربية التي كان يعلم الكرملين أنها ستكرسح الاقتصاد الروسي، ولربما تطال الرئيس الروسي نفسه، لم تردع فلاديمير بوتين عن غَزو أوكرانيا. لكن عندما يبدأ مفعول العقوبات التي ستطال كامل القطاعات وقد تحوّل روسيا الى إيران، عندئذ قد يضطر فلاديمير بوتين الى إعادة الحسابات وإعادة النظر، بالرغم من اعتماده الآن على شركاء أساسيين له في المعركة المصيرية، وفي طليعتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
فالصين، بالرغم من دعمها السياسي لروسيا، فإنها لن تلبّي مغامرات بوتين، لا سيّما بعد أن يفرض الغرب عقوبات ماليّة تدمِّر من يتعامل مع روسيا. لكن إيران جاهزة بالرغم من مخاوفها من تأثير المواجهة الأميركية – الروسية على مصير مفاوضات فيينا لإعادة إحياء الاتفاقية النووية JCPOA ورفع العقوبات عنها. فقد بدأت المواجهة الروسية مع أربع دول تشارك في مفاوضات فيينا – الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا – وانطلقت العمليات العسكرية في أوكرانيا قبل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية فيينا. ليس واضحاً إن كانت التطورات ستؤجِّل أو ستعرقل محادثات فيينا، علماً أن الجميع كان يتمنى الانتهاء منها قبل المواجهة. الواضح أن الكل يلتهي الآن بالأولوية الروسية – الأوكرانية.
بوتين سيحتاج إيران أكثر في مرحلة المواجهة، لأنه يريدها شريكاً سياسياً وعسكرياً وشريك الغاز والنفط في حروب العقوبات. لكن لا يبدو الرئيس الروسي مهتماً الآن بإفشال محادثات فيينا، لأن نجاح المفاوضات سيؤدّي الى تحرير إيران من العقوبات. وبما أن هناك صفقة أسلحة بنحو 8 مليارات دولار بين روسيا وإيران، فإن رفع العقوبات سيكون في المصلحة الروسية. لكن في أي حال، لدى فلاديمير بوتين مشاريع التأثير في أسواق النفط والغاز من خلال الشراكة الروسية – الإيرانية وعبر اختلاق مشكلات كبرى للاقتصاد الأميركي والأوروبي، كما عبر حيل لضرب استقرار الأسواق.
الصين ستكون رابحة في كل الأحوال، ولذلك لن تكون حليفاً لروسيا في حربها مع الغرب. فللصين مشاريعها الخاصة بها في إطار المنافسة مع الولايات المتحدة. وللصين حسابات تختلف عن حسابات روسيا، بالرغم من تعاضد الاثنتين في وجه الولايات المتحدة خاصة، وفي المعركة العامة مع الغرب، فالصين لن تتورّط في حروب الآخرين، عكس إيران. وهي تقرأ المشهد الأوكراني كما يبدو للجميع، باستثناء فلاديمير بوتين وقاعدته الشعبية: ساحة استنزاف attrition لروسيا في أوكرانيا.
الكلام ليس عن حرب سيبرانية لا نعرف معالمها بعد. الكلام هو عن حرب تقليدية تنطلق من مقاومة أوكرانية للقوات الروسية تُنزل الخسائر الكبرى بها، لا سيّما عندما ستحتاج هذه القوات والترسانة الحربية الى إعادة التأهيل إذا تقرّر بقاؤها. فأوكرانيا دولة من 40 مليون نسمة معظمها يكره روسيا، خصوصاً الجيل الجديد ما بعد 1991 وهو الجيل القادر على حرب الاستنزاف. بقاء القوات الروسية للسيطرة على 40 مليون نسمة يتطلّب تكريس نصف مليون جندي روسي للمهمة، وهذا شبه مستحيل.
ربما لهذا يخاف فلاديمير بوتين من احتلال العاصمة كييف التي يقطنها 5 ملايين نسمة. فالكلفة عالية ومصيريّة، لكن قراره هو فرض حكومة تابعة له في كييف بعد قبع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. فكيف؟
المشكلة تكمن في بقاء القوات الروسية في أوكرانيا، عندئذ تغامر روسيا بتكرار تجربة أفغانستان. فكيف يمكن لبوتين السيطرة على أوكرانيا من دون قوات روسية؟ هذه هي المعضلة. الرئيس الروسي أراد تحويل أوكرانيا “محميّة” تديرها حكومة وصاية protectorate تتلقى تعليماتها من موسكو. لكن هذا مشروع لا يبدو قابلاً للتنفيذ، لا سيّما على المدى البعيد. ولذلك، بوتين في ورطة عدم توفّر استراتيجية بقاء لديه، ولا استراتيجية خروج له من أوكرانيا. وهذا خطير جداً على روسيا بحد ذاتها.
بماذا كان الرئيس بوتين يفكّر عندما خاض هذه المغامرة؟ بالتأكيد. كان يفكّر بمجد روسيا السابق وكذلك بعظمة الاتحاد السوفياتي الذي بكى على انهياره. اعتقدَ أن الولايات المتحدة وبقيّة دول الناتو ستخضع وتلبّي مطالبه المعنيّة بالضمانات الأمنية، والتعهّد بعدم توسيع عضوية الناتو، بدءاً بعدم انتماء أوكرانيا اليه، والحد من التعاون العسكري الغربي في أوروبا الشرقية. اعتقدَ أنها ستفعل ذلك أمام الخوف من جبروت روسيا في أوكرانيا. وهو لا يزال يراهن على إكراه الغرب الى طاولة المفاوضات لتلبية مطالبه من خلال تصعيده عسكرياً وتخويفه هذه الدول من حرب أوروبية وعالمية.
المشكلة أن فلاديمير بوتين لن يتراجع بل سيذهب الى أبعد وأبعد، تحت سوط العقوبات وازدياد العزل والإدانة. قد يختلق عذراً لدول الناتو لتتورّط في حرب مباشرة معه، أما على الحدود الأوكرانية – البولندية، أو عبر توريطه أي دولة أوروبية شرقية تنتمي الآن الى حلف الناتو. فالولايات المتحدة وبقية الدول الفاعلة في الناتو تعهّدت الرد عسكرياً إذا ما وسّع بوتين العسكرة الى هذه الدول. وهنا الخطورة، خطورة الانزلاق الى حربٍ شبه عالمية.
الآن، لقد دخلت روسيا الحرب الباردة مع الغرب، وبدأ الغرب إسدال الستار الحديدي عليها عبر عقوبات تمنعها من تطوير قدراتها العسكرية أو تمويل جيشها، وتكبّل كامل اقتصادها وتضعها وشعبها وراء الستار. العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيون تشلّ حركة البنوك والمعاملات المالية للشركات الروسية التي لن تتمكّن من استخدام عملة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وهي عقوبات تدقّ في عصب حياة المواطن الروسي.
العقوبات كبّلت مشروع أنابيب “نورد ستريم2” بين روسيا وألمانيا والذي أراده بوتين وأراده كثيراً. إنها عقوبات تكنولوجية تشلّ قطاع النفط والغاز، الأمر الذي يؤثر جذرياً في هذه الصادرات الروسية. إنها عقوبات تكنولوجية تضرب الإنترنت الروسي الذي يمر 80 في المئة من كابيلات له عبر الولايات المتحدة. عقوبات تمنع روسيا من تصنيع الشرائح chips، الأمر الذي قد يؤثّر في برامج الفضاء الروسية. عقوبات عديدة وكثيرة قد لا يكون الشعب الروسي استوعبها بعد. وهذه أيضاً مشكلة لفلاديمير بوتين.
فالشعب الروسي سيدخل في نفق الظلام الذي لن يخرج منه، لأن لا أفق هناك لتراجع بوتين أو تراجع الغرب. روسيا ستضعف أكثر، فيما الناتو سيزداد وحدةً وقوةً بفضل غزو بوتين لأوكرانيا. سيجد الشعب الروسي نفسه معزولاً عن بيئته الأوروبية، يدفع ثمن حرب الضمانات الأمنية التي جعل منها الرئيس الروسي هوساً له، ويقع ضحية عقوبات تعيده الى زمن الاتحاد السوفياتي. قد لا يدرك الآن وحالاً وطأة العقوبات والعزل والستار الحديدي والحرب الباردة، لكنه سيشعر بها عاجلاً، فماذا سيفعل الشعب الروسي إزاء اقتياد رئيسه له الى الهاوية؟
هذه بداية حرب وليست نهايتها، وبالطبع، إن ميدان المعارك يُملي نتيجة الحرب. قد تكون هناك مفاجآت تقلب الطاولة وتضع الولايات المتحدة والناتو برمّته في موقف أضعف، لا سيّما أن تهمة “الخيانة” تلاحق الناتو، وبالذات الولايات المتحدة، بسبب عدم التدخل عسكرياً لإنقاذ أوكرانيا. ثم إن الكلفة الاقتصادية للدول الأوروبية وللولايات المتحدة ستتربّص بالقيادات الغربية عبر احتجاج قد يعود الى الفكرة الأصليّة التي أطلقت الحرب، وهي عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي. فكثيرون لا يوافقون قياداتهم على أن توسيع عضوية الناتو تستحق حرباً عالمية، وكثيرون أيضاً يتعاطفون مع فكرة دفاع روسيا عن أمنها القومي أمام توسع الناتو، مع أنهم يعارضون قطعاً الرد الروسي عبر الحرب الأوكرانية.
إنها حرب الضمانات الأمنية التي أخذت القارة الأوروبية الى منعطف خطير، لا سيّما بعدما أُغلِقت النافذة الدبلوماسية. المشوار طويل. وللحديث بقية.
النهار العربي
————————–
هل تنزلق روسيا في «المستنقع الأوكراني»؟/ جيمس جيفري
يجب النظر إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه ليس مجرد عدوان وحشي ضد دولة ذات سيادة وانتهاك للقانون الدولي فحسب، وإنما على أنه تحدٍّ للنظام الأمني العالمي بأسره، الذي يقوده الغرب منذ الحرب العالمية الثانية. وعليه، فإنه يعد أكبر تحدٍّ لهذا النظام منذ أزمة الصواريخ الكوبية قبل 60 عاماً. والقضية هنا ليست مقدار ما سوف يستولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه من الأراضي الأوكرانية، ذلك أن الاستيلاء على الدولة بالكامل من شأنه أن يمنح روسيا بضع نقاط مئوية من القوة الاقتصادية، والديموغرافية، وبعض المزايا الجيوستراتيجية، وإنما بتكاليف أعلى في حالة الاحتلال الكامل. ومن شأن الاحتلال المحدود أن يحد من مكاسبه بقدر أكبر لكن مع تكلفة أقل.
ويعتقد بعض المقربين من الإدارة الأميركية أن الروس إذا حاولوا احتلال أوكرانيا بالكامل فسوف ينزلقون إلى مستنقع التمرد، الذي يواجه مقاومة من الشعب الأوكراني، لا سيما إنْ كان مدعوماً بالأسلحة، وغير ذلك من أوجه الدعم من بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر الحدود. وهذا أمر ممكن، وإنما مع اعتبار المحاذير الرئيسية التي يتعين على واشنطن أخذها في الاعتبار. أولاً، نجحت روسيا في إلحاق الهزيمة بالمعارضة السورية فعلياً في الفترة بين 2015 و2018 عبر مزيج من الضربات الجوية الوحشية للغاية التي استهدفت السكان المدنيين الداعمين لقوى المعارضة، إلى جانب دبلوماسية التعامل المرن للغاية مع كل من جماعات المعارضة وجهات الدعم الأجنبية إنفاذاً لسياسة «فرّق تسد» على أرض الواقع. ثانياً، تستطيع روسيا الرد عسكرياً على دول حلف «الناتو» الداعمة لمقاتلي المعارضة الأوكرانية، مما يُنذر بمخاطر اندلاع حرب أوروبية شاملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
بيد أن الخطر الحقيقي ليس الزيادة الطفيفة في قوة روسيا، بل نجاحها في تحدي النظام الأمني الدولي وتقويضه جزئياً. وبالتالي، ففي المقام الأول، جاءت ردود فعل واشنطن، ثم حلفائها في حلف «الناتو»، ثم معظم بلدان العالم، حاسمة للغاية. وإذا ظل العالم متحداً خلف الموقف الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بشجاعة، ولم يفرض عقوبات وأوجاعاً دبلوماسية على موسكو فحسب، وإنما قرر أيضاً فصلها عن النظام الدولي، على غرار المعاملة التي نالتها في الحرب الباردة، فلن تجد روسيا الضعيفة نسبياً سوى خيارات قليلة لمزيد من تحدي النظام الأمني. إلا أن هذا يشكل تأرجحاً كبيراً للمواقف، ولسوف نرى ما هو أفضل حين نقف على كيفية تفاعل العالم مع أزمة الطاقة المحتملة.
لقد تصرف بوتين على هذا النحو بعد مغامرته الأكثر حذراً في جورجيا عام 2008، ثم أوكرانيا عام 2014 والتي لم تسفر عن أي أوجاع تقريباً، فاعتقد أن الغرب ضعيف للغاية، وبلغ درجة من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية تمنعه من رد الفعل والاستجابة. وعلى هذا النحو، يتعين على المجتمع الدولي أن يتوحد الآن إما لإلحاق الضرر به، أو الاضطرار لبذل المزيد من المجازفات والجهود ضده في وقت لاحق، وإلا، على غرار كل بلدان أوروبا الغربية والوسطى، باستثناء بريطانيا بحلول صيف 1940، إما أن تواجه الانهيار وإما الاصطفاف تحت مظلة واحدة مع المعتدي.
أما في الشرق الأوسط، فيتضح على نحو متزايد ضخامة الهجوم الروسي ليس على أوكرانيا فحسب، وإنما على النظام الأمني العالمي الطويل الأجل، ما يشكل ضغطاً على «التحوط» إزاء الولايات المتحدة من جهة، وإزاء روسيا والصين من جهة أخرى، من جانب الدول الإقليمية خلال السنوات الأخيرة. وقد يبدو أن بعض مواقف التحوط لا تزال مترددة في التوحد حيال موسكو من بعض عواصم الشرق الأوسط، لكن المخاطر التي تهدد العالم بأسره تضعها في حالة من التيه الشديد. وبالتالي، إذا حافظت الولايات المتحدة على سياساتها الذكية حتى الآن، التي تجعل روسيا تدفع تكاليف اقتصادية ودبلوماسية لعدوانها، سوف تصطف الدول الإقليمية وراء واشنطن في نهاية المطاف.
إن تركيا هي الأكثر تأثراً بهذه الخطوة الروسية، وبالتالي فقد جاء رد فعلها واضحاً وقوياً. ومن الواضح أن إيران انحازت إلى روسيا، وسيكون لذلك تداعيات في الولايات المتحدة، وفي أوروبا بصفة خاصة. وستكون التبعات الاقتصادية بمثابة سيف ذي حدين، ومن المرجح أن تفيد أسعار الطاقة المرتفعة مُصدّري المواد الهيدروكربونية، غير أن الأضرار الشديدة سوف تلحق بالمستوردين. إن احتمال حدوث انكماش اقتصادي عالمي ناشئ عن العدوان والاستجابة الدولية سوف يضر بجميع بلدان المنطقة بشكل كبير.
الشرق الأوسط
———————————
نحن وبوتين و”شبح تسوشيما”/ رستم محمود
حينما اندلعت ثورات “الربيع العربي”، كانت الدراسات والأبحاث السياسية تربطها جذريا بسلسلة “ثورات التحول الديمقراطي”، التي انطلقت بالأساس من دول شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم، ومنها امتدت مباشرة إلى بلدان أميركيا اللاتينية بعد سنوات قليلة، ومن “اجتاحت” كامل شرق آسيا، ومن بعدها حدثت في بعض الدول الأفريقية، وانتهى بها المطاف في بلدان المجال العربي.
كان سقوط الاتحاد السوفياتي بمثابة انهيار “شبح تسوشيما” في اللعبة الإلكترونية اليابانية الشهيرة. فحسب تلك اللعبة المستندة إلى التراث العسكري/القصصي الياباني، فإن اختفاء ذلك الشبح المقاتل من أول جزيرة يابانية، يُحطم أسطورة مقاتلي الساموري اليابانيين وما يخلقونه من رُعب، وتاليا تتمكن الجيوش المغولية “الغازية” من دخول عمق اليابان وكافة جّزره، تحطيم ثقافته وسوره الحديدي الداخلي، وتاليا تحديثه عبر ربطه بالعالم.
فالاتحاد السوفياتي كان كتلة إمبراطورية مُدججة بالسلاح والإيديولوجية، نموذجاً عن المركزية والمحافظة على الذات ومنع الشراكة مع باقي العالم. حيث كانت مُحصلة أعماله وسياساته تؤدي، ذاتياً أو موضوعياً، إلى قمع القيم الديمقراطية والحريات السياسية، داخلها وفي مختلف بقاع الأرض. وسقوطها الدراماتيكي عام 1992، أدى لأن تندلع ثورات التحول الديمقراطي في مختلف مناطق العالم، وإن بوتائر مختلفة.
على الدفة المقابلة، فإن الثورات المُضادة لهذا الربيع العربي، بدأ من سوريا وليس انتهاء بسلسلة الانقلابات العسكرية والمدنية في باقي البلدان، تلك التي أنهت مرحلة “التفاؤل الديمقراطي”، وأعادت تكريس أنظمة شمولية مركزية، فإنها كانت ذات ارتباط عميق وبدعم واضح من الاستراتيجية الروسية الحديثة المناهضة للحريات والديمقراطيات والثورات الملونة.
تلك الاستراتيجية التي يخطط لها وينفذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبرا إياها آلية عليا لحماية الأمن القومي الروسي (أقرأ أمن واستقرار النظام الحاكم لروسيا)، ومحاولا إعادة تكريس موقع ودور روسيا في المشهد العالمي، تحديدا من خلال خلق وشائج وتحالفات أبوية ورعوية مع الأنظمة الشمولية، وما يشبهها من إيديولوجيات ورؤى وخيارات سياسية داخل هذه البلدان، تلك النابذة للقيم الديمقراطية والحريات العامة ومنظومة حقوق الإنسان.
بهذا المعنى، فإن الحرب التي يشنها الرئيس الروسي راهنا على دولة أوكرانيا، إنما هي بمثابة مُحدد قطعي لمستقبل الحياة السياسية وأفق الحرية وأشكال منظومات الحُكم والسُلطة والإيديولوجيا في منطقتنا، لأنها ستعني جذرياً أياً من الخطين التاريخيين اللذين كان السوفيات/الروسي مصدرهما سينتصر في المحصلة. خط سقوط السوفيات/الروس، أو خط إعادة تشييد المنظومة الإمبراطورية الروسية.
فنجاح بوتين في مراميه الأوكرانية سيعني تسيّد وهيمنة ذلك الشبح المريع الذي يشكله، المؤلف من مزيج قاسٍ من النزعة القومية وآلية الفعل المركزية وهيمنة العسكر على الحياة العامة وأولوية الأمن على الحرية، إلى جانب تأثيراته الجانبية المتمثلة بانتشار الفساد وتراجع مستويات التسامح ودور الثقافة والطبقات الوسطى في الحياة العامة. والعكس صحيح تماماً.
سنتعرض لهذا التحول المتأتي من الفاعلية والمصير الروسي/البوتيني، لأن هذه الأخيرة ذات حضور ومعان وتأثيرات خاصة في منطقتنا، تاريخا وحاضرا. لأنه طوال تاريخنا الأقرب، القرن العشرين، كانت روسيا ذات طاقة تأثيرية مضاعفة على مختلف مجالات الحياة في منطقتما.
فمن طرف كانت روسيا متداخلة في كل الحروب والتوازنات وعلاقات الجماعات الأهلية في بلداننا، المشرقية منها بالذات، كانت روسيا كذلك على الدوام، لكنها فعلياً كانت عضواً من التركيبة السياسية العمومية لبلدان ومجتمعات منطقتنا منذ أواخر القرن التاسع عشر.
كذلك فإن روسيا كانت البلد الحامل لمشعل الماركسية الاشتراكية طوال القرن العشرين. الماركسية الاشتراكية التي كانت بوابتنا وشراكتنا الوحيدة مع العالم في حداثته وخطاباته وصراعاته، نحن الشعوب والمجتمعات التي لم تصلنا من المنجزات السياسية والفكرية لهذا العالم الحديث إلا هذه الماركسية الاشتراكية، كانت زادنا الوحيد، وبذا كانت روسيا بوابتنا الوحيدة ذلك.
فوق الأشياء كلها، فإن روسيا كانت النموذج الأعلى لـ”مناهضة الغرب”، هذه المناهضة التي احتفى بها، وما يزال، الحيز الأوسع للخيال والعقل الجمعي لأبناء منطقتنا. أي أن روسيا تشكل بوحدة من معانيها صورة عن أنفسنا وموقعنا من أكثر ما نعتبره “نداً”، أي الغرب.
لأجل ذلك، وفيما لو تمكنت البوتينية من إعادة تكريس نفسها كقوة هيمنة عالمية، عبر هذا النموذج الذي تنفذه في أوكرانيا راهناً، فإن تأثيراتها ستكون شديدة على الفضاء العمومي لمنطقتنا.
فانتصار البوتينية في أوكرانيا، ستخلق أرضية مناسبة لانتعاش أنظمة تجمع عنف العسكر ومركزيتهم بالكثير من القيم والنزعات التي كان ينادي بها حزب قومي فاشي مثل حزب البعث، الذي كان سليل ورفيق مجموعة من القوى السياسية والإيديولوجية التي نبتت في ظلال الخطابية الفاشية القومية الأوروبية التي تراكبت في منطقتنا مع الشعبوية الشيوعية في أوائل القرن المنصرم، مثل الحزب القومي السوري الاجتماعي في لبنان وحركة الإخوان المسلمين وجماعة مصر الفتاة في مصر، وغيرها الكثير في كل حدب. إلى جانب ما ستكرسه من انتشار واسع لآليات الفساد والنهب العام وتداخل النُخب السياسية الحاكمة مع الشبكات المافيوزية، إلى جانب هجرة الملايين من أبناء الطبقات الأفضل تعليماً والأكثر حداثة ومدنية.
سيحدث ذلك، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الأهلية والقومية والمناطقية في مختلف هذه البلدان أشد أشكال الانشقاق الشاقولي والصراعات البينية، من دون أن يكون ثمة أية بنية أو نزعة إيديولوجية ذات طابع مدني احتوائي، قادرة على بناء وتحصين الفضاء العام من أشكال الشعبوية والعنف التي تفتك بدواخل البلدان. وفي وقت تشهد فيه واحدة من أسوأ موجات الجفاف والتصحر وهجرة ملايين الريفيين إلى المُدن المتروبولية الخالية من أية خدمات أو فرص عمل كافية للجميع.
بمجمل الأمر، فإن المغامرة البوتينية في أوكرانيا بالنسبة لمجتمعات وأحوال منطقتنا هي فعل شديد الذاتية، لأنها تحمل لهم خيارات استقطابية لا حد لها: فأما الحداثة والإنسنة المفعمة بروح التشاركية والتكاملية، في داخل هذه المجتمعات، وفي علاقتها مع كامل الأطر الكونية الباقية، أو الاستسلام لعالم لا يملك إلا البؤس وقيم العنف وسطوة الأقوى.
لا يبدو أن الثلج سيطول أكثر من أسابيع قليلة، ليظهر المرج واضحاً.
الحرة
———————————-

اجتياح أوكرانيا: المعضلات الاستراتيجية/ الحواس تقية
يضع اجتياح أوكرانيا القيادة الروسية أمام معضلات استراتيجية، ترفع من احتمال خروج الوضع عن سيطرتها، ومن تحقق النتائج التي أرادت تفاديها.
وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدفين لاجتياح أوكرانيا: الإطاحة بالقيادة الأوكرانية التي نعتها بالنازية الجديدة وتجريد الجيش الأوكراني من أسلحته. وقد حشد لهذا الاجتياح نحو 190 ألفًا، وشنَّه على ثلاث جبهات رئيسية، من الجهة الشرقية عبر الحدود الروسية المحاذية للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لموسكو، ومن الجهة الشمالية عبر الحدود البيلاروسية القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، ومن الجهة الجنوبية عبر جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود.
تبدو هذه الاستراتيجية مخالفة لاستراتيجياته السابقة في شنِّ الحروب، كما في تدخله العسكري في جورجيا لفصل أبخازيا وأوسيتيا في 2008، ثم في ضم جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين في إقليم دونباس الأوكراني في 2014، وقد تكلَّلت جميعها بالنجاح لأنها تشترك في عدد من الميزات الرئيسية:
يغلب على سكان هذه الأقاليم الانتماء لروسيا؛ إذ يتحدثون اللغة الروسية، ويحمل أعداد منهم جوازات سفر روسية، ويكوِّنون بذلك بيئة صديقة للقوات الروسية، تحفز بوتين على تنفيذ ضرباته من دون تكبد خسائر بشرية.
يوجدون في أطراف دولهم، أبخازيا وأوسيتا في شمال جورجيا، والقرم في جنوب أوكرانيا على البحر الأسود، وإقليم دونباس في شرق أوكرانيا؛ ما يجعل قدرة دولهم على السيطرة عليهم ضعيفة.
توجد هذه الأقاليم بمحاذاة الحدود الروسية، فيسهل على موسكو إمدادها بالعدد والعتاد.
هي أقاليم ذات مساحات صغيرة، لا تحتاج روسيا لقوات كبيرة للسيطرة عليها.
هذه المواصفات ليست متوافرة في اجتياح أوكرانيا:
غالبية سكان البلد يتحدثون الأوكرانية؛ ما يجعل شعورهم بالتميز عن روسيا قويًّا وتمسكهم بالاستقلال عميقًا.
عدد السكان أكثر من 40 مليون، والمساحة 600 ألف كم2، أي أكبر من مساحة فرنسا.
عدد القوات الأوكرانية نحو 196 ألف جندي، وعدد قوات الاحتياط 900 ألف، وقد عملت القيادة الأوكرانية خلال 8 سنوات، أي منذ 2014 على تطوير قدرات قواتها تدريبًا وتسليحًا.
تحاذي أوكرانيا عددًا من دول الناتو المناوئة لروسيا، مثل بولندا ورومانيا، فتحصل منهم ومن خلالهم على الدعم الاقتصادي والعسكري، وتحول دون تطويق روسيا لها.
من المقارنة يبرز نموذجان: الغزوات السابقة على اجتياح أوكرانيا كانت خاطفة، والاستراتيجية تتصف بالحذر، أما اجتياح أوكرانيا فسيكون طويل الأمد ومرتفع المخاطر لأن أهدافه شبيهة بأهداف الاتحاد السوفيتي في أفغانستان خلال ثمانينات القرن الماضي أو الاحتلال الأميركي للعراق في بداية الألفية، وهي تغيير النظام وتفكيك الجيش.
هذا الاختلاف يجعل القيادة الروسية أمام معضلات استراتيجية، تتلخص في الجملة الشهيرة: يمكن لشخص واحد أن يعلن الحرب لكن إعلان السلام يحتاج إلى اثنين. استطاع بوتين بمفرده أن يقرر اجتياح أوكرانيا لكنه لن يستطيع بمفرده أن يقرر السلام فيها.
عقد متشابكة
هذه المعضلة الرئيسية هي حصيلة عدد من المعضلات، الأخلاقية والسياسية والاستراتيجية، التي تُوقِع القيادة الروسية في تناقضات، تجعلها غير قادرة على السيطرة على مجريات الاجتياح، وقد ترتد عليها تداعياته.
المعضلة الأخلاقية: دأب بوتين على انتقاد استعلاء الغرب، ويعتبره غير مؤهل لتقديم الدروس، لأنه ينتهك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي التي التزم باحترامها، ويذكر مثال الغزو الأميركي للعراق. وقد أكسبه هذا النقد تعاطفًا دوليًّا واسعًا لأنه يعبِّر عن مواقف عدة دول تخشى على سيادتها من التدخل العسكري الغربي، لكن اجتياحه أوكرانيا هو انتهاك للقانون الدولي، والأهداف التي وضعها للاجتياح هي أيضًا إملاءات على الأوكرانيين كي يسلِّموا بما تختاره لهم موسكو.
ستتضرر أكثر أهلية بوتين بعد هذا الاجتياح لانتقاد الاستعلاء الغربي من أجل كسب التعاطف الدولي، وقد يكتفي في المستقبل بالرد على الغربيين بأنهم ليسوا أفضل منه فقط.
المعضلة السياسية: إذا نجح بوتين في تغيير النظام الأوكراني ووضع حكومة موالية له، سيواجه نفس المعضلة السياسية التي واجهها الاتحاد السوفيتي في أفغانستان والولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، وهي أن الحكومة الأوكرانية الجديدة ستكون ضعيفة سياسيًّا، وستواجه مقاومة داخلية، وتظل بحاجة إلى الدعم الروسي، فيزداد ضعفها كلما زادت تبعيتها لموسكو، وقد يتكرر سيناريو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لما سقطت الحكومة الموالية لموسكو بعد انسحاب القوات السوفيتية، أو كما وقع في أفغانستان أيضًا لما سقطت الحكومة الموالية للولايات المتحدة عندما قررت واشنطن سحب قواتها.
لا تقتصر المعضلة السياسية على أوكرانيا بل تشمل روسيا أيضًا، فلقد برزت عدة مؤشرات على أن الرئيس بوتين لم يجهز جبهته الداخلية لاجتياح أوكرانيا، من هذه المؤشرات الارتباك الذي بدا على جلسة مجلس الأمن القومي الروسي الذي انعقد خصيصًا لاتخاذ القرار، فلقد ظهر أن مدير الاستخبارات الروسي لم يكن على دراية بموضوع الاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين في أوكرانيا، وتدخل بوتين عدة مرات ليخبره بما ينبغي عليه قوله، وكذلك تفادت القيادة الروسية تسمية الاجتياح بالحرب بل دعته بالعملية العسكرية الخاصة؛ لأن كلمة الحرب تحمل ذكريات مفزعة للشعب الروسي، وتقتضي أن هناك مواجهة عسكرية بين دولتين، أما تسمية العملية العسكرية الخاصة فقد تطلق على عملية لمواجهة إرهابيين أو لإنقاذ رهائن أو غيرها من العمليات المحدودة والخاطفة، وقد هددت القيادة الروسية بالحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تواصل تسمية الاجتياح بالحرب أو الغزو، في دلالة على أن الرهانات ليست لغوية بل استراتيجية، تتعلق بطمأنة الشعب الروسي إلى أن الاجتياح محدود وسريع. علاوة على أن رفض القيادة الروسية اعتبار الاجتياح غزوًا أو حربًا هو محاولة لتجنب التبعات القانونية الدولية التي تعتبر الحرب خارج القانون الدولي عدوانًا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التنديد به ومنعه، ويمنح الدولة المعتَدَى عليها حق الدفاع عن النفس وشرعية المطالبة بالدعم الخارجي. من المؤشرات كذلك على أن بوتين لم يوفر الدعم السياسي الداخلي لاجتياح أوكرانيا المظاهرات التي ينظمها الروس الرافضون للحرب والتي منعها الأمن الروسي بالقوة.
المعضلات الاستراتيجية: في المدى القصير، تكشف مجريات العمليات القتالية أن القيادة الروسية أخطأت في تقدير شدة المقاومة؛ إذ لم تحقق تقدمًا كبيرًا منذ بدء العملية في 24 فبراير/شباط، رغم قصر المسافة بين القوات الروسية القادمة من بيلاروسيا والعاصمة كييف، وقد برز هذا الارتباك في التقدير في تصريحات القيادة الروسية التي جعلت تفكيك الجيش الأوكراني هدفًا من أهداف اجتياحه لكنها طلبت منه، مع تباطؤ تقدم قواتها، الإطاحة بالحكومة الأوكرانية لتسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي الاجتياح.
قد تكون قدرة المقاومة الأوكرانية الحالية على التصدي لتقدم القوات الروسية مؤشرًا على شدتها مستقبلًا لما تتحلَّل من الدفاع عن المدن، وتتحول إلى استراتيجية الكَرِّ والفَرِّ، لإطالة أمد الحرب، وتحويل أوكرانيا إلى مصيدة للقوات الروسية. يصفون هذا التحول في الاستراتيجية بمبادلة الأرض مقابل الوقت، ففي الدفاع عن المدن تكون الأولوية لحماية الأرض أما استراتيجية المقاومة أو حرب العصابات فتكون الأولوية بكسب الوقت مقابل التخلي عن الأراضي.
على المدى المتوسط، يرى استراتيجيون -مثل إدوارد لوتواك- أن القوات الروسية التي تشن الاجتياح أقل من عدد القوات الضروري لتحقيق الأهداف التي أعلنها بوتين، ويستنتج أن أقصى ما تستطيع هذه القوات تحقيقه هو السيطرة على المدن الرئيسية، وتظل مساحات شاسعة من أوكرانيا خارج سيطرتها، فتستعملها المقاومة الأوكرانية لشن هجمات على القوات الروسية، فتوقع بها خسائر كبيرة، لن تحتملها القيادة الروسية، ويضرب مثالًا على تخوف القيادة الروسية من وقوع عدد معتبر من القتلى في صفوف قواتها بما وقع في حرب الشيشان لما انسحبت القوات الروسية بعد أن سقط في صفوفها مئة قتيل. يفسر علماء الاجتماع ذلك بشيخوخة المجتمع الروسي الذي بات حساسًا لفقدان فئاته الشبابية. وإذا طال بقاء القوات الروسية في أوكرانيا للقضاء على المقاومة فإن التكلفة البشرية ترتفع فتزداد الضغوط الداخلية على بوتين.
من العوامل التي ترجح استمرار المقاومة الأوكرانية حتى لو سيطرت القوات الروسية على المدن الرئيسية: مجاورة أوكرانيا لدول أعضاء في الناتو ومناوئة لروسيا، وتخشى من أن انتصار روسيا في أوكرانيا قد يشجعها على مواصلة توسعها في دول أخرى مثل مولدافيا، لذلك ستحرص على استنزاف روسيا في أوكرانيا بالمقاومة حتى تنهك روسيا وتجعلها تفقد الرغبة في خوض حروب أخرى، وأقصى ما تتطلع إليه هو الانسحاب المشرِّف من أوكرانيا.
على المدى البعيد، قد يؤدي اجتياح أوكرانيا ليس إلى إضعاف الحلف الأطلسي كما كان بوتين يأمل بل إلى تقويته، فلقد تنادت دوله للتضامن، وقرر بعضها كبولندا زيادة الميزانية المخصصة للدفاع، وطلبت دول إسكندنافية، السويد والنرويج، الانضمام إليه، وقد كانت من قبل زاهدة في ذلك، وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في أوروبا بدفع مزيد من قواتها إلى دول الحلف المجاورة لروسيا.
يتضح عزم الدول الغربية في العقوبات الجماعية التي فرضوها على عدة قطاعات حيوية روسية، قطاع البنوك وقطاع التكنولوجيا المتطورة، وشاركت في هذا المسعى تايوان التي تتفوق في صناعة أشباه الموصلات الضرورية للأسلحة المتطورة، وقد تتزايد العقوبات فتقطع بولندا الطريق الذي يربط بين ألمانيا وروسيا، فتتوقف حركة البضائع، وقد اتفقت الدول الغربية على إخراج قطاعات روسية من نظام سويفت للتبادلات المالية، فتصيبها بالشلل.
سيضطر التشدد الغربي الرئيس بوتين للاعتماد أكثر على الصين، كما اتضح في تعهد الصين بشراء الفائض من القمح الروسي الذي قد ينتج عن العقوبات الغربية، والارتباط المتزايد بين الروبل الروسي واليوان الصيني لتفادي التعامل بالدولار الأميركي، لكن هذا الاتجاه يجعل روسيا مكشوفة أمام التهديد الصيني في المستقبل؛ لأن هناك تفاوتًا بين البلدين في حجم السكان، وتقع كتل سكانية صينية كبيرة على حدود سيبيريا التي تعاني من نقص السكان الروس، وينبِّه الاستراتيجيون إلى أن هذا التفاوت قد يحفز الصين إلى السيطرة على هذه المناطق الغنية بالنفط الذي تحتاجه لاقتصادها، وقد شبَّه زبينيو بريجنسكي هذه الوضعية الاستراتيجية بـأن روسيا ستكون محطة بنزين للصين.
مخاطرة كبيرة
مختلف هذه المعضلات تجعل الرئيس بوتين يواجه وضعًا غير مسبوق، لا يسيطر على مختلف مجرياته، وقد ترتد على نظامه في المدى المتوسط، وتضعف روسيا على المدى الطويل.
رغم ذلك، قد يفاجئ بوتين الجميع بتحركات لم تكن في الحسبان، تقلب الوضع لصالحه، وإن كانت المعضلات المذكورة سابقًا تحد من قدرته على المناورة بشكل غير مسبوق، وتجعل احتمالات فوزه ضعيفة.
الحواس تقية
باحث بمركز الجزيرة للدراسات، مشرف على دراسات العالم العربي. حاصل على بكالوريوس إعلام. ترأس تحرير عدد من الصحف الجزائرية المستقلة. نشر عددا من المقالات والدراسات في الصحف والمجلات الجزائرية حول القضايا السياسية والاستراتيجية. شارك بأوراق بحثية في عدة مؤتمرات دولية حول الشؤون السياسية والاستراتيجية.
————————————
لماذا تخوض روسيا الحرب مجدداً؟/ كريس ميلر
لا يوجد زعيم عالمي اليوم يتمتع بسجل أفضل فيما يتصل باستخدام القوة العسكرية مقارنةً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسواء ضد جورجيا عام 2008، أو أوكرانيا عام 2014، أو في سوريا منذ 2015، فقد حوّل الجيش الروسي مراراً وتكراراً النجاح في ساحة المعركة إلى انتصارات سياسية. لم تكن إعادة تسليح روسيا خلال العقد ونصف العقد الماضيين متناسبة مع زيادة مماثلة في القدرات الغربية. وليس من المستغرب أن تشعر روسيا بالجرأة لاستخدام قوتها العسكرية بينما يقف الغرب موقف المتفرج.
حروب روسيا الثلاث الماضية هي أمثلة بارزة على كيفية استخدام القوة العسكرية بطرق محدودة لبلوغ المقاصد السياسية. استمر غزو جورجيا في عام 2008 خمسة أيام فقط، لكنه أجبر الدولة على تقديم تنازلات سياسية مهينة. وفي أوكرانيا عام 2014، نُشرت الوحدات العسكرية النظامية الروسية على نطاق واسع لبضعة أسابيع، وثبت أنه تصرف كافٍ لإرغام كييف على التوقيع على اتفاق سلام مؤلم. عندما تدخلت روسيا في سوريا عام 2015، توقع بعض المحللين الغربيين وقوع كارثة على غرار الغزو السوفياتي لأفغانستان، الذي بدأ في 1979 وانتهى بعد عشرية موجعة في مستنقع آسن إلى الانسحاب المهين. بدلاً من ذلك، كانت الحرب الأهلية السورية بمثابة ساحة اختبار لأكثر الأسلحة الروسية تطوراً.
على مدى العقد الماضي، اعتقد الأميركيون أن قوة روسيا تكمن في تكتيكات هجينة، مثل الحرب السيبرانية، والحملات الإعلامية المضللة، والعمليات السرية، وقدرتها على التدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى. لكن بينما كنا نبحث عن الأشباح الروسية وراء كل تدوينة مضللة على «فيسبوك»، نجحت القيادة الروسية في استبدال بالجيش غير المجهز الذي ورثته عن الاتحاد السوفياتي قوة قتالية حديثة تستعين بكل شيء من الصواريخ الجديدة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة. واليوم، فإن التهديد على أمن أوروبا ليس حرباً هجينة، بل قوة صارمة، ظاهرة في صواريخ «كروز» القوية التي ضربت مختلف أنحاء أوكرانيا.
يقول جيك سوليفان، مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، مؤخراً: «نحن نملك 50% زيادة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي»، مقارناً ذلك بحصة روسيا غير المبهرة والبالغة 3% فقط من الناتج الاقتصادي العالمي. غير أن الاقتصادات لا تخوض الحروب، لكن الجيوش تخوضها. لقد اختُبرت قوة أميركا الاقتصادية عندما هدد بايدن بفرض عقوبات صارمة إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، ولقد فعل بوتين ذلك على أي حال، مراهناً بأن القوة الصارمة سوف تكون المسيطرة.
ما من شك أن الجيش الأميركي يملك جنوداً أفضل تدريباً وأنظمةً أكثر قدرةً في مجملها. غير أن ما يهم ليست المقاربات العسكرية النظرية وإنما القدرة على استخدام القوة لتحقيق أهداف محددة. لقد طوّرت روسيا على وجه التحديد القدرات اللازمة لإعادة بناء نفوذها في أوروبا الشرقية. وفي الوقت نفسه، رأت الولايات المتحدة أن حيز المناورة المتاح لها في المنطقة يتقلص بشكل مطرد، وتحيط بها أنظمة روسية مضادة للطائرات وتهديدات الحرب السيبرانية والإلكترونية.
إن ترك التوازن العسكري في أوروبا يتحول لصالح روسيا كان خياراً. والواقع أن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً من اللوم عن هذا. وحتى بعد هجمات روسيا الأولى على أوكرانيا في 2014، كانت التعزيزات الأميركية في القارة كافية فقط لإبطاء وتيرة التحسن في الوضع الروسي. لقد تولت إدارة بايدن مسؤولية خفض الإنفاق العسكري بمجرد النظر في مسألة التضخم. قد تبدو ميزانية الدفاع الأميركية البالغة 700 مليار دولار تقريباً مثيرة للإعجاب، لكنّ روسيا لديها ميزة تتمثل في دفع مبالغ أقل لرواتب الجند والمعدات تُنتج محلياً. وللتكيف مع هذه الاختلافات، نمت ميزانية الدفاع الروسية بسرعة أكبر بكثير من ميزانية الدفاع الأميركية على مدى العقدين الماضيين. وهناك المزيد الذي يتعين على الحلفاء الأوروبيين أن يتحملوا المسؤولية عنه، والإفاقة من وهم أن السلام حق مكتسب. لقد كانوا يملكون قوة قتالية كبيرة، وقد حان الوقت لإعادة بناء هذه القدرات.
ربما يكون بوتين قد تخطى حدوداً كثيرة بمحاولة ابتلاع أوكرانيا بالكامل. إذ إن احتلال أوكرانيا لمدة طويلة من شأنه تعظيم القدرات الروسية، لا سيما أن مزاياها العسكرية سوف تكون أقل أهمية مع تحول الصراع إلى المدن الأوكرانية المكتظة بالسكان. ومع ذلك، لا ينبغي أن نفترض ببساطة أن أوكرانيا سوف تتحول «لأفغانستان أو عراق بوتين»، نظراً لأن قادة آخرين قد ارتكبوا أخطاءهم بأنفسهم. كان بوسع بوتين ببساطة اختيار تدمير أوكرانيا ويترك الغرب يتعامل مع التداعيات. لكنّ الواقع أن أوكرانيا المفككة والمختلة قد تتناسب تماماً مع المصالح الروسية. لقد خضعت الحروب الأخيرة التي خاضتها روسيا لحسابات دقيقة بعناية بالغة وتكاليف محدودة للغاية. ولا يوجد ضمان لأن هذا الصراع الراهن لن يكون كذلك.
كانت استراتيجية الولايات المتحدة في نشر المعلومات الاستخباراتية العامة حول التعزيزات العسكرية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا خطوة ذكية، لكنّ بوتين تمكن من كشف محاولة الخداع. كان من الشائع في الماضي السخرية من الرئيس الروسي بسبب نظرته إلى العالم الراهن كما لو أنه في القرن الـ19، لكن استخدامه القوة العسكرية لتعزيز نفوذ روسيا نجح أيضاً في القرن الـ21. إن افتراض الغرب أن قوس التاريخ ينحني في اتجاهه بشكل طبيعي يبدو ساذجاً. وينسحب نفس القول على القرار بالسماح للميزة العسكرية بالانفلات. صحيح أن القوة الناعمة والنفوذ الاقتصادي يشكّلان قدرات جيدة لاكتسابها، ولكنها لا تستطيع وقف المدرعات الروسية في طريقها إلى كييف.
* خدمة «نيويورك تايمز»
الشرق الأوسط
———————————–
اجتياح أوكرانيا أكبر خطأ يرتكبه بوتين وهو ما سيطبع إرثه/ ماري ديجيفسكي
إذا سارت العمليات العسكرية على ما لا يُشتهى أو لو تأثر مستوى المعيشة سلباً فإن الرئيس الروسي يخاطر بموجة إحباط شعبية أو حتى وقوع انقلاب ضده
كتبت في صحيفة “اندبندنت” قبل أسبوع من اليوم، واستنتجت في خلاصة تحليلي حول فشل الغرب حتى في محاولة فهم روسيا اليوم ورئيسها فلاديمير بوتين على هذا النحو: “إذا اجتاحت روسيا الأراضي الأوكرانية، فإن تلك العملية لن تكون نزهة جميلة حلم بالقيام بها الرئيس بوتين لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي السابق، كما أنها لن تكون عملية اتخذ القرار بتنفيذها في لحظة غضب جراء شعوره بسوء المعاملة لتلقين الأوكران درساً. خطوة الرئيس بوتين لا تعكس هاتين الحالتين- رغم كثير من النظريات الخطأ التي تفيد بالعكس- فهو ليس [زعيماً] يحن للزمن الإمبريالي، وهو ليس مقامراً. لكنه يجتاح أوكرانيا لأنه كرئيس لروسيا يعتقد أن أمن بلاده مهدد- ومهدد ولنبعد هنا أي مجال للشك، وأن مصدر هذا التهديد هو نحن [في الدول الغربية]”.
الاجتياح قد وقع الآن. ووفق التقارير الأولية، نجحت روسيا في شن هجوم على عدة جبهات استهدف خصوصاً مواقع عسكرية في الساعات الأولى لفجر الخميس. وهذا يشير إلى أن القيادة الروسية قد لجأت إلى ما يعرف بخيار الحد الأقصى، وأن الهدف منه يذهب إلى أبعد بكثير من تعزيز السيطرة الروسية على مناطق الشرق في إقليم دونباس الأوكراني بالتزامن مع ترك بقية أنحاء البلاد وشأنها.
هدف موسكو يبدو أنه ليس أقل من تحييد أوكرانيا عسكرياً وضمان، من وجهة النظر الروسية، أن البلد لا ولن يشكل في المستقبل المنظور- أي خطر أمني على روسيا.
حالياً هناك كثير من الغموض، بما في ذلك إن كانت خطة بوتين تقضي بإطاحة الحكومة المنتخبة بطريقة ديمقراطية [حالياً في كييف]، أو إذا ما كان بوتين ينوي الإبقاء على قوات روسية لتحتل أجزاء [إضافية] من أراضي أوكرانيا، أو أن تلك القوات ستحتل كامل التراب الأوكراني. ولا يبدو واضحاً أيضاً في هذه المرحلة ما إذا كان الأوكرانيون سيتمكنون من القتال أو إذا كانت لديهم النية بذلك. حلف الأطلسي والولايات المتحدة وإلى جانبهما المملكة المتحدة كانوا قد قالوا بكل وضوح، خلال الأسابيع الماضية، إنهم لن يرسلوا جنوداً للقتال في أوكرانيا، وإن أي رد من تلك الدول سيكون مقتصراً على تدابير مثل فرض العقوبات.
وفي الإمكان القول، إن ذلك أعطى بشكل من الأشكال ضوءاً أخضر لموسكو. لكن البعض يعتقدون أن مقداراً من الغموض لا يزال يلف هذا الأمر.
ولكن ما يجب أن يكون واضحاً حالياً، هو أن شن القيادة الروسية هجوماً على أكثر من محور ضد دولة مستقلة- ودولة بحجم مساحة أوكرانيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 44 مليون نسمة نجحوا مرتين خلال الأعوام العشرين الماضية في الانتفاض بنجاح ضد حكومتهم التي كانوا يعارضونها- فإن بوتين يدخل في مغامرة كبيرة [قد تهدد موقع] روسيا وموقع زعامته.
اليوم يمكن القول، إن الخطط الروسية قد تم وضعها بعناية من وجهة النظر العسكرية، وهي خطط تحمل في طياتها أهدافاً محدودة يمكن تحقيقها خلال فترة قصيرة من الزمن نسبياً ومن دون مواجهة أي مقاومة تذكر. هكذا كان الوضع يوم سيطرت روسيا وبنجاح على شبه جزيرة القرم عام 2014- مدعومة بالطبع وهنا يجب الاعتراف بذلك، من قبل كثير من أهالي [القرم] المحليون المؤيدون لروسيا. وبشكل مماثل ربما ستحظى العمليات التي تسعى لتقويض قدرات أوكرانيا العسكرية بنفس الحظوظ من النجاح، مما يمنح الرئيس بوتين نصراً إضافياً وقد يكون نصراً أعظم- والذي يمكنه البناء عليه ليخرج من المشهد السياسي بشكل يمجد [فيه التاريخ الروسي] انتصاراته المضيئة [التي حققها للأمة].
لكن، سيكون من الصعب أن تكون كل تلك الاحتمالات مضمونة. فأوكرانيا ليست شبه جزيرة القرم. وأكثر من ذلك، لا بد من الإشارة إلى ما قاله بوتين في بيانه الذي أعلن فيه عن بدء العمليات العسكرية، فهدف روسيا لا يقتصر فقط على مجرد جعل أوكرانيا دولة “منزوعة السلاح”، لكن تسعى روسيا بحسب ما أطلق عليه بوتين مساعيها لــ”اجتثاث النازية” denazification في أوكرانيا- مظهراً عبر ذلك سردية روسية تقول، إن أوكرانيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي قد سمحت بنمو تيار جماعات اليمين القومي التي تعود أصولها إلى حقبة الثلاثينيات في أوروبا. نعم إن مثل تلك الجماعات موجودة في أوكرانيا ولديها بعض التأثير، ولكن هذه الجماعات تبقى هامشية.
تتمتع أوكرانيا بحكومة منتخبة ديمقراطياً، ورئيسها فولوديمير زيلينسكي Volodymyr Zelensky، هو من أصول يهودية. محاولات الدولة الروسية اليائسة لتعريف الحكومة الأوكرانية على أنها والدولة مرتبطتان بصعود النازية تجافي الحقيقة. وإذا كانت روسيا تنوي الانخراط في ما سماه الرئيس بوتين “اجتثاث النازية” denazification، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص وربما يلاقون مصيراً أسوأ من الاعتقال- مما يعني أن العملية العسكرية ستصبح أكثر تعقيداً، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها على المحتل الروسي.
السبب المركزي الذي حملني أنا وأقلية من الخبراء الغربيين، ولا مناص من القول، إنهم أقلية، [المهتمين بمتابعة الشأن الروسي] على اعتبار أن العمل العسكري العلني ضد أوكرانيا مستبعد، هو أن مثل هذا المشروع بدا لنا محفوفاً بالمخاطر، ويتعارض في كل شكل من الأشكال مع مصالح بوتين وروسيا على حد سواء. فالاعتقاد أن العملية العسكرية لوحدها ستؤدي وباختصار إلى إنهاء ميل أوكرانيا وطموحاتها إلى التطلع غرباً، وإعادة صوغ [هيكلة] الدولة بشكل يتناسب أكثر مع رغبات روسيا يشكل على أقل تقدير تهديداً كبيراً للجانب الروسي، ويحمل في طياته ربما حسابات كارثية في غير محلها.
وعلى الرغم من كل جهود الرئيس بوتين واستعراضاته المسرحية خلال ظهوره التلفزيوني مجتمعاً مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الإثنين الماضي، لتقديم عملية اتخاذ القرار الجماعي الذي مهد الطريق أمام انطلاق العمل العسكري، فإن المسؤولية الكاملة جراء ما سيلي من أحداث تقع على عاتق الرئيس الروسي والقائد الأعلى للبلاد وحده. وإذا سارت الأمور بشكل يظهر فيه خطأ الحسابات [الروسية]، فإن الخطأ سيكون خطأ بوتين نفسه، ومن دون أدنى شك- ومن منظور روسي بحت- سيكون ذلك أكبر الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الروسي خلال عقدين ناجحين من ولايته على رأس السطة الروسية حتى الآن.
الصعوبات العسكرية- مثل أن تغرق القوات الروسية في وحل أوكرانيا، وأن يرتفع حجم الخسائر [الروسية] أو أن تتطور الحرب إلى حرب عصابات في المدن- سيطيح وبسرعة بكل بريق العملية العسكرية بأي نجاحات أولية قد تسجل. إن الشهية الروسية للحرب- أقله، شن الحرب ضد دولة جارة حيث لكثيرين روابط عائلية وصداقات- أمر ليس مؤكداً على الإطلاق- على الرغم من تصوير الحملة العسكرية كنضال عصرنا هذا للحيلولة من دون صعود النازية قد يساعد على إقناع أجزاء قليلة من الرأي العام الروسي. فيما أنه لو قررت روسيا الانسحاب وإعلان النصر- تاركة الدول الغربية للملمة الجراح ودفع فاتورة الأضرار وإعادة بناء البلد- فمن شأن ذلك أن يحد من حجم الضرر [الذي قد يلحق بالقيادة الروسية الحالية] إلى حد ما، ومن نتائج هذا السيناريو بالنسبة لروسيا سيكون وفي أحسن الظروف، دولة أوكرانية جارة مدمرة وفقيرة.
أوكرانيا ما بعد الاجتياح الروسي ستكون معادية بشكل عام لروسيا بشكل أكبر مما هي كانت عليه. إحدى مشكلات الرئيس بوتين مع أوكرانيا أنها اليوم تعمل على بناء حسها القومي، على الأقل في الجزء الذي يصور روسيا على أنها الدولة العدوة، راهناً وتاريخياً. هذا الشعور سيزداد بين الأوكرانيين وسيكون لديهم ما يبرر مشاعرهم تلك بعد هذا الاجتياح الروسي.
وإذا سارت موسكو في مشروعها لتنصيب حكومة “دمية” موالية للحكومة الروسية [في كييف]، فذلك قد يساعد طوال الفترة التي سيكتب لتلك الحكومة القدرة خلالها على الصمود، فيما هي تعاني في مساعيها التعامل مع شعب حاقد وغير متعاون إذا لم نقل إنه منتفض تماماً ضد النظام الجديد شأنه شأن أي نظام يعتبرونه محتلاً. في المحصلة، لقد “خسرت” روسيا اليوم أوكرانيا حتى بشكل أكبر مما كان عليه الحال [قبل الاجتياح]، وموسكو قامت عملياً في التنازل عنها على الأمد الطويل [ورمتها] في أحضان التكتل الغربي.
وفي النظر إلى الأمور بشكل أوسع، فعبر اجتياحها أوكرانيا أعادت روسيا التأكيد على إعادة إنعاش [رص صفوف] التحالف الغربي الذي كان في طور التفكك، إضافة إلى زيادة عدد الدول التي قد تنضوي ضمن حلف الأطلسي مثل فنلندا والسويد وهما واقعتان على حدود روسيا الشمالية. منذ اليوم ولسنوات مقبلة ستتحول روسيا إلى دولة منبوذة عالمياً، يتم استثناؤها من العلاقات الدبلوماسية والتجمعات الاقتصادية ويتم تجاهلها من قبل الدول الغربية التي كانت تسعى موسكو دوماً للفوز باحترامها.
الرئيس بوتين- شأنه شأن كثير من الروس- قد يعارض هذه السردية، فمن وجهة نظره قد تمت معاملة بلاده كدولة “خارجة عن سرب (الإجماع) الدولي” outsiders بغض النظر عن أي تنازل أو انفتاح تقدمه روسيا من جانبها، ولذلك لم يعتقد أن هناك ما يخسره في الأصل. وروسيا ستتحول إلى أطراف أخرى، وشركاء مفيدين أكثر، مثل الصين والهند أو دول أفريقية صاعدة أخرى. انعطافة من هذا النوع قد تترك موسكو أقل عزلة مما قد يكون عليه الحال بعد اجتياحها أوكرانيا، لكن ذلك لا يتطابق مع صورة روسيا عن نفسها التي ترى دوماً أنها دولة أوروبية [بامتياز].
بالنظر إلى ما سبق، فإن اجتياح أوكرانيا يفرض على بوتين واحدة من أصعب المنعطفات خطورة خلال حكمه الذي استمر حتى الآن عشرين عاماً. ويعود الفضل في بقائه على سدة السلطة طوال هذه الفترة إلى قدرته على استشعار المزاج الروسي وفهم مطلباتهم حتى قبل أن يشعروا في الحاجة إليها، ولكن أيضاً لقدرته على تأمين نوع من الاستقرار في حياة الناس ورفع مستوى المعيشة، ونجاحه أيضاً في إدراج روسيا على الخريطة الدولية [استعادة مكانتها].
من خلال اجتياحه أوكرانيا، من المؤكد أن بوتين نجح في تدعيم مكانته ومكانة روسيا على الخريطة العالمية. لكن لو اتجهت العمليات العسكرية نحو الفشل، أو لو بدأ مستوى المعيشة الروسي في التراجع، فسيكون مهدداً نتيجة الإحباط الشعبي أو عرضة لانقلاب في القصر. رغم الجهود لتقديم الاجتياح على أنه جاء نتيجة قرار جماعي للقيادة الروسية، ليس من الواضح بعد حجم الدعم الذي يحظى به هذا الاجتياح في أوساط طبقة النخبة الروسية، ناهيك عن الموقف الشعبي العام الذي لطالما كان مشككاً في أي مغامرة عسكرية.
لكن بالنسبة لبوتين نفسه، فإن حساباته قد تكون مختلفة. كرئيس لروسيا، فهو ربما يعتقد بصدق إضافة إلى بعض زملائه من أبناء جيله أن خيار دولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف الأطلسي يعتبر تهديداً مباشراً ووجودياً بالنسبة لبلاده. وهو كان قد وصف عضوية أوكرانيا في حلف ناتو “خطاً أحمر” روسياً. وبسبب هذا فإنه قد يستنتج أنه من خلال اجتياح أوكرانيا فهو يحمي روسيا. ولذا ربما يكون بوتين مقتنعاً تماماً أنه قد قام بالخيار الحكيم، حتى ولو كلفه ذلك منصبه وسمعته كزعيم روسي ناجح. من هذا المنظور، فإن الحكم النهائي على ما يجري لن يصدر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة لتحديد ما إذا كان اجتياح أوكرانيا خطأ أم لا، بل قد يترك هذا الحكم إلى الأجيال المقبلة.
———————————–
دروس سورية يمكن تعلمها في أوكرانيا
حتى الأمم المتحدة أدارت ظهرها لإدلب وقدمت المساعدات للأسد
قال هاميش دي بريتون غوردون، الخبير في الأسلحة الكيماوية، إن الأزمة السورية تستمر دون أن يلاحظها أحد، رغم أنها تحمل في طياتها دروساً مهمة للغاية للغرب بخصوص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنها مرت تقريباً دون أن يلاحظها أحد في باقي أرجاء العالم.
وعدّ الخبير، في مقال نشره بموقع صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تستمر في ظل ديكتاتورية ترعاها روسيا، في وقت يرغب فيه بعض القادة في إعادة بشار الأسد، مهندس هذه الجرائم، إلى مجتمع المقبولين دولياً. وأنه في خضم الاستجابة لحالة الطوارئ في أوكرانيا، ثمة دروس يمكن للغرب أن يتعلمها، ويجب أن يتعلمها، من الوضع القائم في سوريا.
دي بريتون غوردون، الذي هو أيضاً زميل «الكلية المجدلية بكامبريدج» والمستشار في «اتحاد الجمعيات الخيرية الطبية السورية»، يلفت إلى أنه منذ أن قضت الأمم المتحدة على مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية عام 2014، واصل الأسد قصف المستشفيات والمدارس وحرق القرى على الأرض، في إطار سياسة الأرض المحروقة المروعة على غرار ما كان يجري في العصور الوسطى. ويقول إنه «لحسن الحظ، لم نشهد استخدام أسلحة كيماوية منذ أبريل (نيسان) 2019». ومع ذلك؛ تبدو سوريا اليوم دولة روسية في كل شيء ما عدا الاسم، «أما الأسد فهو ديكتاتور دمية، ومن الواضح للغاية أن الخيوط المتصلة به يجري تحريكها من موسكو» على حد تعبير الكاتب. واليوم، تبقى إدلب، المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، المنطقة الوحيدة التي لا تزال بمنأى عن الاستبداد، إلا إنه في ظل وجود ملايين الأرواح المحاصرة هناك والتي تكابد سوء التغذية، وإلقاء الأسد عليهم أسلحة حارقة كما لو كانوا حشرات، «ما زالت إدلب أشبه بجحيم على الأرض». ولفتت المقالة إلى أنه حتى الأمم المتحدة أدارت ظهرها لإدلب، وقدمت المساعدات للأسد وزوجته لتوزيعها على النحو الذي يريانه مناسباً. واليوم، تمثل سوريا كياناً سورياً وإيرانياً كبيراً على حافة أوروبا. وإذا سقطت أوكرانيا هي الأخرى، فسوف يتحول ميزان القوى إلى حد كبير نحو الشرق. وفي ظل اعتماد كثير من الدول الأوروبية على الغاز الروسي، يتضح أن حالة عدم الاستقرار العالمي الراهنة بدأت في دمشق. من الواضح أن روسيا تشعر بجرأة أكبر مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، وتبدي استعداداً أكبر للوقوف في وجه «الناتو» مما كانت عليه قبل بضع سنوات، عندما لم يكن جيشها البالي يضاهي الدبابات الغربية.
وفي الوقت الذي أقدم فيه الباقون منا على تقليص جيوشنا، والاعتماد بدلاً من ذلك على الإلكترونيات والفضاء لخوض الحرب المقبلة، حرصت روسيا على تحديث قواتها المدرعة، والتي تظهر الآن في جميع أنحاء أوكرانيا. ويشدد الكاتب على أن سوريا تكشف لنا النتيجة التي تظهر على الأرض، عندما تغض الطرف وتسقط تحت تأثير دعاة السلام على نحو مفرط. واليوم، ننظر إلى سوريا ونحن نعي جيداً أنه كان ينبغي علينا القيام بعمل أفضل. ويجب أن تكون هذه المعرفة مصدراً لاستجابتنا لعدوان بوتين الجاري الآن.
ويتابع دي بريتون غوردون أنه عند مناقشة قضية سوريا مع السوريين من إدلب والمناطق التي يسيطر عليها النظام، يتضح أن الجميع قد عانى الأمرين، على الأقل اليوم نجد أن سكان إدلب يحصلون على الدعم من خلال تركيا، وهناك بعض المشروعات المبتكرة التي تمولها دول أوروبية. ويحظى العديد من المستشفيات والعيادات في إدلب في الوقت الحاضر بالطاقة الشمسية لتشغيل مولداتها وغرف العمليات الجراحية، بسبب عدم توافر الوقود وتعرض شبكة الكهرباء للتدمير منذ سنوات. كما أن هناك سيارة كهربائية، تعمل بالطاقة الشمسية، تتولى توزيع الأدوية ولقاحات فيروس «كوفيد19»، عندما تكون متوفرة في بعض الأحيان حول إدلب.
وفي تحول ملحوظ لن يحدث إلا في الحرب، يعرض الآن بعض هؤلاء الأطباء السوريين الذين طوروا نظاماً طبياً قادراً على البقاء في ظل أكثر الظروف صعوبة، تقديم يد العون في أفغانستان. ويثني الكاتب على الشعب السوري «الذي أظهر قدرة كبيرة على الصمود والابتكار لا مثيل لها، حتى بعد أن تعرضوا للخذلان مراراً وتكراراً»، مستشهداً بأنه، في البداية، لم يتدخل الغرب عندما بدأ النظام مهاجمة شعبه.
وبعد ذلك، ورداً على استخدام الأسلحة الكيماوية، أعلنت الولايات المتحدة خطاً أحمر بشأن استخدامها، لكنها فشلت في التصرف عندما جرى خرق هذا الخط. وأخيراً، يقول: «وقفنا متفرجين بينما تشق روسيا وإيران طريقهما عبر سوريا لإنشاء قاعدة عمليات أمامية على أعتابنا».
—————————
الطاسات الإلكترونيّة للحماقة/ سمير التقي
كتب لي صديق رأيه الذي يقول:
” التحالف الألماني – الروسي من شأنه أن يُسرّع انحدار القوة العظمى التي تقترب حالياً من الهاوية. هذا هو السبب في أن واشنطن مصممة على بذل كل ما في وسعها لتدمير “نورد ستريم-2” وإبقاء ألمانيا في مدارها. إنها مسألة بقاء. فرّق تَسُد، هنا يكمن موقع أوكرانيا في الصورة العامة للوضع الراهن”.
“هذه الاستراتيجية مأخوذة من الصفحة الأولى من كتيب السياسة الخارجية الأميركية تحت عنوان: “فرّق تَسُد”. تحتاج واشنطن إلى خلق تصوّر بأن روسيا تشكل تهديداً أمنياً لأوروبا. هذا هو الهدف. إنهم بحاجة لإثبات أن فلاديمير بوتين “معتد”، “متعطش للدماء”، “صاحب مزاج صعب” ولا يمكن الوثوق به. ولهذه الغاية، تم تكليف وسائل الإعلام بالترويج مراراً وتكراراً لمقولة إن “روسيا تخطط لغزو أوكرانيا”. ما لم يُقَل بعد هو أن روسيا لم تغزُ أي دولة منذ تفكك الاتحاد السوفياتي”.
“هذا يعني أنه سيكون هناك نوع من الاستفزاز يهدف إلى حث بوتين على إرسال قواته عبر الحدود للدفاع عن الروس في الجزء الشرقي من البلاد. إذا بلع بوتين الطُعم، فسيكون الرد سريعاً وقاسياً”.
وكتبت:
من المفيد أن نكف عن الاعتقاد أن الأميركيين بشر خارقون، أو أنهم يسيطرون على عقول الزعماء، وأن نكف عن إلباسهم لباس السوبرمان. إنهم ببساطة أولاد السوق، بعيدون من أي منطق عقائدي غيبي بمختلف أشكاله. إنهم ليسوا إلا براغماتيين انتهازيين. وهم يواجهون خصومهم العقائديين الذين يبحثون عن الأمجاد، بكل برود ومتعة منقطعة النظير. وهم يصرحون بذلك علناً، لكن القليل يقرأون.
إنهم لا يلبسون الزعماء الحمقى طاسات إلكترونية تسيطر على عقولهم. فلا هم لعبوا بعقل هتلر ليهاجم أوروبا، ولا لعبوا بعقل جمال عبد الناصر ليسحب جنوده من شرم الشيخ، ولا بعقل بريجنيف ليهاجم أفغانستان، ولا بعقل صدام حسين ليغزو الكويت، ولا بعقل بن لادن ليهاجم مركز التجارة العالمي، ولا أميركا تلعب بعقل الصين لتوتر من دون طائل الوضع في بحر الصين وتضطهد الأيغور ليلغموا المجتمع الصيني ويعززوا التحالف ضد الصين، ولا هم الآن يتلاعبون بعقل بوتين ليحشد مئات الآلاف من الجنود على حدود أوكرانيا ثم يدّعي أن أوكرانيا تهاجم أنصاره.
وفي المقابل، فإنهم يعلمون جيداً خطر الأوهام العقائدية عندهم في مجتمعهم، والتي منها بالطبع الأوهام العقائدية للبيض في المجتمع الأميركي والتفرقة وتفاوت مستويات التطور بين مختلف شرائح المجتمع الأميركي، إنها ولا شك الخطر الأكبر الذي يواجهه الأميركيون. وكما قلت فإنهم، في رأيي، براغماتيون انتهازيون من الطراز الأول، وهم لا عقائديون بالتعريف. إنهم يستهزئون بالعقائديين. لكنهم يستنزفونهم كل صباح، ويرفعون كؤوسهم كل المساء.
من هذا المنطق لا يضيرهم ركام نظريات المؤامرة في شيء، فذلك يعزز حماقة الخصوم ويعميهم عن رؤية الحماقة. ولا يهم في هذا السياق أن يهاجم العالم الأميركيين من منطق المؤامرة الكبرى، ما دامت سفاراتهم تعج بطلبات الهجرة. فنظرية المؤامرة تخدم أميركا بهدفين. الأول هو إحباط الخصوم، والثاني هو تسريع الانزلاق نحو الحماقة الأيديولوجية. لذلك، إذ ينزلق خصومهم أبعد في أوهامهم العقائدية، يتصرف الأميركيون ببرود.
فإن كانت حملات العقائديين مفيدة، فلا بأس، وليكن! ولكن إن كانت عقائديتهم تضر بمصالح الأميركيين، فإنهم ينتظرون اكتمال الظروف، ليضربوا ضربتهم بأقل التكاليف وأكبر المكاسب. المنطق والتجربة التاريخية معهم يفيداننا بأن ثمة حمقى أيديولوجيين يبحثون عن الأمجاد التاريخية التليدة. الأميركيون يستفيدون من حماقتهم، سواء باستخدامها إن كان الأمر مناسباً، أو أنهم يتركونها لتتورم وتتفاقم حتى تتجاوز الممكن التاريخي والموضوعي، لتصبح مستحيلة، ثم ليضربوا ضربتهم.
هذا حين ينجحون، وهم لا ينجحون إلا في الحروب الكبيرة. وفي كل مرة دخلوا فيها حروباً صغيرة خسروا، لأن دولتهم هي قوة بحرية كونية بالتعريف، أما حروبهم البرية الصغيرة فكانت بدورها أصل أخطائهم.
وفي براغماتيتهم، ولا عقائديتهم، فإنهم يبحثون عن المكاسب بمعناها الاستراتيجي المباشر. ذلك أنهم يحاولون أن يضعوا خصومهم أمام أحد خيارين، إما أن تسير في اتجاه معين، أو أن تذهب للحماقة. ثم، ينتظرون.
ينتظرون الآخرين ليركبوا الحماقات الأيديولوجية ونظريات المؤامرة، فإن تحامقوا تسارع انهيارهم وخسروا.
لقد نجح هذا النهج مع الصين 1974 حين اختارت الطريق الأول، ونجح مع روسيا حين اختارت الطريق الثاني الخ…
أما ألمانيا فموضوعها مختلف تماماً. عرقلت أنغيلا ميركل كثيراً محاولات المجابهة مع روسيا. وكانت دوماً تفضل احتواءها من دون مجابهة. أما من منظور دول أوروبية أخرى مثل بولندا ودول البلطيق وجورجيا بل وأوكرانيا، فلقد كانت السياسة الألمانية تتم على حساب أمن الدول الأوروبية الصغيرة.
في المنظور الأميركي كان هذا الموقف الألماني مفهوماً، ويساعد في حسم خيارات روسيا في اتجاه إيجابي. ومع الزمن تطور الموقف الأميركي لتفقد الولايات المتحدة الأمل نهائياً في امكان احتواء روسيا، واحتمال تدرجها لتتحول دولة طبيعية، تسير على إيقاعها نحو نموذجها الخاص من الليبرالية والديموقراطية.
لكن الموقف الألماني في حينه استمر يتجاهل استمراء روسيا موقف ألمانيا، بحيث مضت روسيا قدماً في تفكيك الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.
وصل هذا الأمر إلى حد أن الولايات المتحدة أصبحت تقول إذا كنتم لا تجدون خطراً في روسيا، فاذهبوا وتدبروا أنفسكم معها منفردين في الوضع الاستراتيجي وجابهوا وحدكم المطامع الروسية في أوروبا. وإلا، إذا كنتم شركاء، فلتشاركوا في تحمل الأعباء! وهذا ما حمله ترامب الى قمة الأطلسي. ولا يختلف بايدن كثيراً مع هذا المنطق، إلا من حيث الأسلوب والحرص أكثر على الأطلسي.
بعد رحيل ميركل بدأ تحوّل بطيء في ألمانيا. حزب الخضر الشريك الأساسي في التحالف الحاكم في ألمانيا متشدد بقوة ضد الأطماع الروسية. وشولتس ليس بعيداً من ذلك. وفي حين أن السفينة الكبيرة لا تنعطف بسرعة، فإن سلوك بوتين الراهن يسرّع الانعطاف.
نعم لقد سرّعت روسيا، بحماقة السياسات، في تحقيق الأهداف الأميركية الاستراتيجية في إعادة اللحمة الى إيقاع الحلفاء في أوروبا.
لكن الطاسة الإلكترونية التي تجعل بوتين يخطئ هي من صنعه هو.
إنها الطاسات الأيديولوجية نفسها التي نبيع منها كثيراً في شرقنا الأوسط ولكن بنقوش مختلفة.
—————————-
غزو أوكرانيا: بوتين النووي في مواجهة الديموقراطية/ إيلي عبدو
بوتين، كشف عن نزوع غير عقلاني بعد تهديده بالنووي، وهذا سلوك لا يستقيم مع صانع استراتيجيات وخطط تتعلق بالثروات والتراكيب السكانية، بقدر ما ينطبق على دكتاتور يطمح لأن يكون توتاليتاريا، فيما الروس ضحاياه الأكثر تضرراً.
ليست الديموقراطية في أحسن حالاتها في الغرب.
صعود اليمين الشعبوي بموازاة سوء الأوضاع الاقتصادية، وتجربة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السلبية مع المؤسسات في أميركا، والأسئلة التي طرحتها إجراءات “كورونا”، كلها مؤشرات، إلى مشكلة تتبلور أكثر وأكثر داخل الدول الغربية. لكن انعكاس هذه المشكلة يتبدى بشكل آخر على عدد من المثقفين والمحللين العرب، إذ إن هؤلاء لا يبنون مقاربتهم على أسباب ضعف الديموقراطية، قياساً بشرط الداخل الغربي فقط، وإنما بتعامل الحكومات الغربية مع الشرق الأوسط، و”تهاونها” مع المستبدين فيه، وقبولها التعامل معهم. فتكمل بالنتيجة، صورة تسفيه الديموقراطية، وعزلها عن أي صراع أو صدام، فالغرب يعاني في ديموقراطيته، ويتجاهل معاناتنا مع “مستبدينا”، ويضع يده بيدهم.
وعليه، الديموقراطية بلا معنى، وجميع القوى متشابهة والمصالح هي الأساس. هذا التحليل برز بشكل لافت، عند مقاربة الغزو الروسي البوتيني لأوكرانيا، وتحكّم بالكثير من المواقف، التي تسابق أصحابها للحديث عن الغاز ومخاوف موسكو من انضمام كييف إلى حلف الناتو، والتاريخ المشترك بين البلدين وتداخل التراكيب السكانية، في تغييب متعمد لطبيعة النظام الغازي وطبيعة الدولة التي تتعرض للغزو، واقتراب كل منهما من تطبيق الديموقراطية، وابتعاده منها.
أصحاب هذا التحليل، يتجاهلون أن الديموقراطية في الغرب ليست قيمة مجردة أو معزولة، بل هي مرتبطة بالشرط السياسي والاقتصادي، فصعود اليمين وتراجع الاقتصاد، قد يضعفانها، وتقدم الوسطيين والليبراليين، وازدهار الاقتصاد يجعلانها أقوى. ويتجاهلون أيضاً أن الديموقراطية لا تحل المشكلات بقدر ما تسمح بتظهيرها وإدارتها ضمن تسويات ومن دون عنف. في أذهان هؤلاء، الديموقراطية، ليست ديناميكيات تتأثر ببنى، هي تجريد شعاراتي، يشبه ذلك الذي درج مع بداية الربيع العربي، حين راحت النخب تتحدث عن ضرورة الديموقراطية، من دون ربطها بأوضاع الجماعات وحساسياتها.
مسألة الهوية التي يبيعها الرئيس الروسي لشعبه، لا يمكن مقاربتها بمعزل عن الديمقراطية، إذ يستخدمها بوتين ضمن عدته، ولا تتطور بشكل طبيعي مثلما يمكن أن يحدث في أوكرانيا .
الفهم الثابت، للديموقراطية، يمكن أن يساعد، على فهم النقد الذي نوجهه للغرب في التعامل مع النظم الديكتاتورية في منطقتنا، فهو يوازن بين مصالحه وقيمه، وتتفاوت مواقفه تبعاً لهوية من يحكم وظروفه، إلى عوامل أخرى. هذا، ليس لتبرير مواقف مدانة، بطبيعة الحال، طالما أنها، تتهاون مع المستبدين، لكنها محاولة لربط هذه المواقف مع ديناميكيات الداخل الغربي وتفاعلاته، والتي، تؤثر أيضاً في الديموقراطية، قوة وضعفاً. وبالنتيجة، تغييب مسألة الديموقراطية انطلاقاً من ضعف هذه القيمة في الغرب، مبني على فهم مغلوط، واستنتاجات متسرعة، تفصل الديموقراطية عن الشرطين السياسي والاقتصادي، وتحيل الغرب إلى مبشر دائم بها.
لكن حتى ثنائية ديمقراطية – دكتاتورية، تحتاج لتطوير لمقاربة مجدية للغزو الروسي لأوكرانيا. فالأخيرة، ليست دولة ناجزة ديمقراطياً، مسارها الفعلي بهذا الشأن بدأ عام 2014، في الوقت نفسه روسيا البوتينية ليست دكتاتورية كلاسيكية، هي دكتاتورية توسعية معطوفة على نزوع إمبراطوري متخيل، تستخدم مرتزقة هنا وهناك، وتشن هجمات الكترونية وتتدخل في مصائر الانتخابات في عدة دول.
دكتاتورية بوتين تجنح نحو التوتاليتارية دون أن تكونها بالضرورة. شبه توتاليتارية تستفيد من التكنولوجيا ومواقع التواصل للتضليل والتأثير على الرأي العام الغربي، وكذلك من أسواق المال عبر زرع شركات في بورصات الغرب تخدم مصالح الكرملين. نظام بوتين يتغذى من عناصر حديثة، دون أن يتخلى أن عناصر توتاليتارية كلاسيكية تتعلق بقضم بلدان مجاورة. من هنا، فإن غزو بوتين لأوكرانيا مرتبط بطبيعة نظامه، أكثر مما هو مرتبط بالتحليلات الإستراتيجية التي انتشرت بكثافة في الصحف، خلال الأيام الماضية.
الأرجح أن المسألة معكوسة، بمعنى، أن التحليل الاستراتيجي بكل عناصره، يمكن أن يدرج ضمن أجندة بوتين شبه التوتاليتارية، الغاز والثروات لتمويل مشاريع التوسع، والتناقضات والاختلافات المتعلقة بالسكان، ذرائع للتدخل، والخوف من “الناتو”، عائق أمام المشروع الإمبراطوري. وكل ذلك، لحرف الانتباه عن مشاكل الداخل وإقناع الروس بأوهام تاريخية، على حساب حريتهم وازدهارهم الاقتصادي، تمهيداً لفضلهم عن واقعهم الموضوعي وخلق واقع مواز مبني على صناعة الكذب البوتينية.
مسألة الهوية التي يبيعها الرئيس الروسي لشعبه، لا يمكن مقاربتها بمعزل عن الديمقراطية، إذ يستخدمها بوتين ضمن عدته، ولا تتطور بشكل طبيعي مثلما يمكن أن يحدث في أوكرانيا التي يتحسر الممانعين العرب على وجود قوميين فيها، هؤلاء القوميون يمكن أن تستوعبهم الديمقراطية الوليدة ومؤسساتها وتخفف تطرفهم، عكس الهوية في روسيا التي يتحكم فيها طموح بوتين السلطوي.
أسبقية عنصر الديمقراطية على التحليلات الاستراتيجية، تكشفت بوضوح أكثر، مع متابعة مقاومة الأوكرانيين لغزو بلادهم، إذ دافع أهالي كييف ومدن أخرى عن أنفسهم ضد التحليلات التي تسعى لتغييبهم، دافعوا عن حقهم بالأوربة وبتجربة الديمقراطية الوليدة التي حاول كثر تسخيفها.
في المقابل. تبدت التحليلات الاستراتيجية ، أقل معنى، خصوصا وأن بوتين، كشف عن نزوع غير عقلاني بعد تهديده بالنووي، وهذا سلوك لا يستقيم مع صانع استراتيجيات وخطط تتعلق بالثروات والتراكيب السكانية، بقدر ما ينطبق على دكتاتور يطمح لأن يكون توتاليتاريا، فيما الروس ضحاياه الأكثر تضرراً.
درج
——————————–
السيل الإيراني الشرقي/ حسن فحص
دخول طهران على خط توريد الطاقة تحديداً الغاز إلى أوروبا لن يواجه صعوبة في التنفيذ
فيما لم تمرّ على عودة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ساعات من قمة الدول المصدرة للغاز “أوبك للغاز” (GECF) التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن ليعلن حزمة ثلاثية من العقوبات ضد روسيا بعد قرار نظيره فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
لعل الأخطر في قرارات البيت الابيض ما أعلنه بايدن صراحة عن نهاية مشروع “السيل الشمالي 2” الذي من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى أوروبا.
وعلى الرغم مما لهذا القرار من انعكاس سلبي على أمن الطاقة في القارة الأوروبية، إلا أن بايدن، وقبل الذهاب إلى هذا الخيار، عمد خلال الأسابيع الماضية، بخاصة لدى استقباله أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى الوقوف على قدرات الدول المصدرة للغاز بتعويض الغاز الروسي وتلبية الحاجات الأوروبية.
رئيسي وفي كلمته أمام قمة “GECF” السادسة، أكد أن “استراتيجية إيران الإقليمية تقوم على رفع إنتاج وتصدير الغاز”، وأن بلاده “تعلن استعدادها للتحوّل إلى ممر آمن لانتقال الغاز بين المنتجين والأسواق المستهلكة”، إلا أن وزير النفط في حكومته جواد أوجي كان أكثر صراحة ومباشرة في هذه النقطة، إذ أعلن استعداد إيران لأن تكون مصدراً ومعبراً للغاز باتجاه دول الجوار والدول الأوروبية.
وبعيداً من الاستعجال في الحكم بإمكان حصول قطع أو تباعد بين طهران وموسكو في المرحلة المقبلة، من الموضوعي التعامل مع هذا الموقف أو إعلان الاستعداد من زاوية البحث الإيراني عن مصالحه الاقتصادية والقومية والاستراتيجية، وهذا لا يعني أن طهران في طور التفكير بالتخلي عن تعاملها مع موسكو أو حتى الاقتراب من هذه الاحتمالية، بل هي خطوة تنسجم مع الاستراتيجية التي وضعها النظام والحكومة الحالية في عدم وضع كل “بيضها” في سلة واحدة، بخاصة أن أبرز وأهم الانتقادات التي تُوجّه إلى الرئيس السابق حسن روحاني أنه عمل وفريقه لوضع كل البيض الإيراني في السلة الغربية، وسعى إلى عرقلة السير في عقد التفاهمات الاقتصادية الاستراتيجية مع كل من روسيا والصين.
ومن منطلق المصالح القومية، وفي محاولة لاستعادة موقعها على خريطة الطاقة والأسواق العالمية، لن تتردد إيران في اعتماد هذا الخيار، بخاصة أنها كانت تشاهد على مدى الأعوام الماضية، وفي مرحلة العقوبات المشددة كيف أن المنتجين الآخرين للغاز والنفط عملوا على سد الفراغ الذي تسبب فيه غيابها عن الأسواق العالمية.
وإعلان طهران عن هذه الاستعداد، وأن تكون معبر ترانزيت الغاز إلى جانب تصديره باتجاه أوروبا، قد لا يعني الدخول في مواجهة مع موسكو أو المساهمة في تضييق الحصار عليها بعد العقوبات الأميركية، بل من الممكن أن تتحوّل إلى حاجة روسية، كما كانت روسيا حاجة إيرانية في مرحلة العقوبات المشددة، للالتفاف على هذه العقوبات، ومدخلاً إيرانياً لتعويض ما خسرته من فرص في قطاع الطاقة وحاجة الأسواق الدولية.
الموقف الإيراني الذي يأتي في وقت تجمع كل الأطراف الدولية المعنية بالمفاوضات النووية الجارية في فيينا على اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق الجديد، إلى حد أن البعض منهم دخل في توقيتات لا تتعدى اليومين، 25 فبراير (شباط)، هذا الموقف يبدو أنه منسجم مع حجم هذا التقدم، ويعبّر عن استعداد طهران للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بخاصة الأوروبي في تقديم البدائل في حال اندلاع أزمة طاقة في قطاع الغاز الذي بات يشكل العصب المحرك لكثير من الاقتصادات الأوروبية.
في المقابل، فإن هذا الانفتاح الإيراني لم يأتِ من خارج السياقات التي مهّدت للتقدم في مفاوضات فيينا، وإن الجانب القطري لعب دوراً واضحاً في هذا الإطار. فاستعادة الحراك الذي جرى قبل أسابيع، من زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى إيران قبل أيام من زيارة أمير قطر إلى واشنطن، لا يمكن أن تحصل من دون أن تكون لدى الجانب القطري مؤشرات جدية إلى نيّة الطرفين في التوصل إلى تفاهم يتجاوز الموضوع النووي. وهو الذي وجد ترجمته في المواقف الإيرانية للرئيس ووزير النفط الإيرانيين في قمة الدوحة للغاز.
الدخول الإيراني على خط توريد الطاقة، تحديداً الغاز، إلى أوروبا، لن يواجه صعوبة في التنفيذ، بخاصة أن الجانب الإيراني أكد وجود بنية تحتية تساعد على هذا التنفيذ السريع بالاعتماد على شبكة الأنابيب الداخلية التي أنشأتها إيران لهذه الإمدادات، إضافة إلى التفاهمات والاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها، ممثلة برئيس الجمهورية مع أذربيجان وتركمنستان قبل أشهر على هامش قمة “إيكو”، لنقل الغاز من هذه الدول وتوريده إلى الأسواق العالمية عبر مياه الخليج، سواء عبر الأنابيب أو من خلال عملية “سواب” “SWAP” من ناحية، وإمكان رفع مستوى الضخ في الأنبوب المستخدم في تزويد تركيا بالغاز، ما يسهّل عملية نقله إلى أوروبا.
هذه التطورات قد تعيد إحياء الآمال الإيرانية بإمكان تفعيل خط أنابيب “نابوكو”، بخاصة بعد الاكتشافات الجديدة لحقل الغاز الضخم في الجزء الإيراني من بحر “الخزر” (قزوين)، الذي يعيد تصنيف إيران بين أكبر الدول التي تملك أعلى احتياطي للغاز في العالم. وهي آمال تضاف إلى الآمال التي قد تنتج من ترجمة مفاعيل العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا ومخرجان قمة”GECF” ، بالتالي ربما تجعل من إيران بديلاً لخط “السيل الشمالي الثاني”، واستبداله بخط السيل الإيراني الشرقي.
———————-

إنذار بوتين النووي: علامة قوة أم ضعف؟
فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم مجددا بإصداره أمرا بوضع قوات الردع النووي الروسية في «حالة تأهب قتالية خاصة».
القرار، حسب بوتين، جاء ردا على مسؤولي حلف «الناتو» الذين أدلوا «بتصريحات عدوانية ضد روسيا» وذلك بعد أن اتخذ المسؤولون الغربيون «خطوات عدائية اقتصادية».
بالعودة إلى آخر التصريحات التي صدرت عن مسؤولي حلف شمال الأطلسي «الناتو» نجد تصريحا لأمينه العام، ينس ستولتنبرغ يقول إن الحلف يقوم بنشر وحدات قوة الرد أرضا وجوا وبحرا للرد بشكل سريع على أي حدث طارئ، وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن رومانيا هي المرشحة لإرسال قوات برية إليها، كما ستتوجه بعض تلك القوات إلى النرويج «للمشاركة في تمرين».
هناك تصريح ثان، صدر في اليوم نفسه (25 شباط/فبراير) لستولتنبرغ يطالب الروس بعدم الانجذاب لدعاية الرئيس بوتين، وأن الحرب على أوكرانيا «لن تجعل روسيا أكثرا أمانا أو احتراما» وكذلك تصريح يقول فيه إن الوثيقة التأسيسية للعلاقات المشتركة والأمن بين الناتو وروسيا «قد عفا عليها الزمن في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا».
لقي قرار بوتين الخطير ردود فعل غربية تراوحت بين وضع الناطقة باسم «البيت الأبيض» جين ساكي، للقرار ضمن سياق «فبركة تهديدات غير موجودة من أجل تبرير مزيد من العدوان» وبين إدانة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي رأت فيه «تصعيدا غير مقبول» وصولا إلى رد الأمين العام للناتو نفسه الذي قال إنه «بيان خطير» و«سلوك غير مسؤول».
التصعيد خطير فعلا، فهل يتناسب في القوة مع المبرّرات التي أدت إليه؟
من الصعب، بداية، أن نتخيل أن الرئيس الروسيّ يفترض أن أوروبا، والغرب، وكذلك المنظومة الديمقراطية في العالم، ستقف مكتوفة الأيدي أثناء «العملية الخاصة» التي يقوم بها جيشه، والتي ستؤدي إلى احتلال دولة أوروبية ذات سيادة (ناهيك عن كونها محسوبة على منظومتها السياسية).
يمثّل هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا تطوّرا عسكريا وسياسيا هائلا بشكل يتجاوز التدخّلات العسكرية الروسية السابقة في جورجيا وكوسوفو وسوريا وأوكرانيا نفسها (مع احتلال شبه جزيرة القرم ومناطق شرق البلاد عام 2014) ويمكن القول إن بوتين قد اجتاز خطا أحمر بشكل يضطر أوروبا والغرب وحلف شمال الأطلسي (المتهمة أصلا بالتخلي عن أوكرانيا) للتحرك.
لا يمكن، مع ذلك، اعتبار التحرّكات العسكرية المحدودة التي قام بها حلف الأطلسي، أو تصريحات مسؤوليه، سببا كافيا لرفع درجة التأهب القتالي الروسي إلى درجة استخدام «الردع النووي».
الأغلب أن انزعاج سيّد الكرملين الأساسي ناتج عن عدم تمكّن جيوشه من حسم الحرب بسرعة، وعدم نجاح دعواته للجيش الأوكراني بالانشقاق على القيادة السياسية، إضافة إلى تشكّل مقاومة شعبيّة داخلية حتى في المناطق الشرقية التي كانت روسيا تفترض أنها تضم حاضنة شعبية مناصرة لها.
ترافقت هذه العناصر المعاكسة للاجتياح مع ازدياد التعاطف العالمي مع الأوكرانيين، وكذلك تنامي المظاهرات المناهضة للحرب داخل روسيا نفسها، وكذلك مع قرارات اقتصادية وسياسية (ورياضية) عالمية موجعة لإدارة بوتين، تدرّجت من العقوبات ضده شخصيا، وضد المسؤولين الروس الكبار، وبدأت تقترب الآن من إعلان «خيار نووي» اقتصادي وهو إخراج روسيا من نظام سويفت المالي، الذي سيكون ضربة كبرى للاقتصاد الروسي.
قرار بوتين، ضمن هذا السياق، هو علامة ضعف لا قوّة، فالسلاح النووي لا جدوى له فعليا في الصراعات الطرفية، وقد هزمت قوى نووية كبرى في أرض المعركة بحيث لم تستطع ترساناتها الضخمة تقديم العون لها، كما حصل مع أمريكا في فييتنام والاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
الحروب النووية مستحيلة لأنها تعني انتحارا مشتركا بين أطرافها، والتلويح بها، على طريقة بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي، أو «ردا على تصريحات» هو تعبير عن الضعف وليس القوة.
————————-
الحرب النووية..خارج المحرّمات/ ساطع نور الدين
ثبُت بما لايدع مجالا للشك، أن ما يفصل بين تعقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين جنونه، شعرة واحدة، إذا ما إنقطعت، إثر شدها بالامس على هذا النحو الموجع، تهدد بإحراق كوكب الارض بمن عليه.
ومن الآن فصاعداً باتت تلك الشعرة التي لاحت في أفق الازمة الاوكرانية العالمية، دليلاً جديداً على أن بوتين فقد رشده، وإن لم يفقد عقله بعد، وأصبح مصير البشرية معلقاً بقرار يتخذه في لحظة غضب أو توتر.. أو ربما في لحظة تأمل في أحوال الكوكب وسكانه الكثر.
بالطبع، هي ليست المرة الاولى التي يجري فيها تفعيل السلاح النووي المنتشر في العالم ،منذ الحرب العالمية الثانية، والذي كانت أميركا سباقة الى استخدامه ضد اليابان، وكانت روسيا السوفياتية نفسها لاحقة في التهديد به، خلال أزمة الصواريخ الكوبية، في ستينات القرن الماضي، مثلما كانت إسرائيل في حرب تشرين العام 1973 جدية في التلويح به، ثم في تحويله الى مادة للتسريب والترهيب، قبل أن تقف الهند وباكستان في نهاية القرن الماضي، على حافة أول حرب نووية..
يخطىء من يظن أن بوتين لن يتورع عن إستخدام سلاح يوم القيامة. هو نفسه لم يدع الفرصة لأحد كي يخطىء في الظن: كأنه كان يتلهى بلعبة Call of Duty الشهيرة لرواد ال”بلاي ستايشن”، أو كان يمارس هوايته الحربية في سوريا او جورجيا او كازخستان، يحرك وحدات عسكرية جوية او بحرية أو برية لتنفيذ مهام محددة بجغرافيا معروفة. لم يجد مبرراً لدعوة مجلس وزرائه الى عقد اجتماع عاجل، ولا دعوة البرلمان بمجلسيه الى عقد جلسة طارئة لمناقشة أو على الاقل للمصادقة على قراره المفاجىء الذي يؤثر على مستقبل نحو 135 مليون مواطن روسي، ومئات الملايين ، بل المليارات من سكان الكرة الارضية. إكتفى فقط بتوزيع فيديو ظهوره بوجه خال كالعادة من التعابير ، سوى التجهم، وهو يورد الجمل القليلة التي أملاها على وزير دفاعه المطيع سيرغي شويغو وقائد الجيش الروسي المطواع، ويأمرهما بوضع سلاح الردع النووي في حالة تأهب قصوى.
لم يدم ذلك الفيديو سوى دقيقة واحدة، كانت كافية ليدخل العالم في منعطف حاسم، يعيد الى الاذهان على الفور تلك الضربة الاميركية النووية المزدوجة التي أهلكت اليابان، ويترك الانطباع العفوي، المرعب، بأن العالم أصبح بالفعل على عتبة حرب نووية، ستكون الاولى من نوعها في التاريخ، والاخيرة طبعا..لأن أحدا لن يبقى بعدها لكي يواصل التدوين البشري.
لم تكترث الدول او الشعوب البعيدة عن “الثقافة” الذرية، بأوامر بوتين المذهلة، ولم تأخذها على محمل الجد، ظناً منها أنها ستظل بمنأى عن ذلك الخطر الداهم، لكن الدول التي خاطبها الرئيس الروسي تخطت المفاجأة بسرعة، وشرعت على الفور في البحث المعمق عما يمكن أن يردع بوتين، عن اللجوء الى الخيار النووي، وعما يمكن ان يحمي شعوبها من الضربات النووية المدمرة، وعما يمنع الصواريخ الروسية العابرة للقارات من دخول اجواء عواصمها ومدنها الكبرى.
المؤكد ان جميع الدول النووية، لا سيما الاعضاء في حلف شمال الاطلسي، أصدرت بالامس أوامر فورية مشابهة، وأبلغت حكوماتها وبرلماناتها ، ولاحقا شعوبها، بأنه لا يمكن الاطمئنان الى ان بوتين يناور أو يخادع، أو حتى يفاوض. المنطق يحكم، والتجربة تؤكد أن الاجراءات الوقائية ضرورية، لأن عنصر المفاجأة غير مستبعد في حالة الصراع مع روسيا المصابة بهوس استعادة صفتها السابقة كدولة عظمى، لم تعد تملك من مقومات تلك العظمة سوى أسلحتها النووية الفتاكة، التي تلوح باستخدامها جدياً هذه المرة لكي تتفادى أن تحولها الحرب الاوكرانية الراهنة الى دولة من العالم الثالث.
لم يعد خيار الحرب النووية متوهماً، صار حقيقة يفترض التعايش معها، نمط الحياة الجديد في مختلف أنحاء الكرة الارضية..عدا ربما القطب الجنوبي وحده الذي قد يكون محطة السفر الاخيرة الى كوكب آخر .
المدن
——————————–
احتلال روسي لأوكرانيا وحرب عصابات لاستنزافه/ عبد الوهاب بدرخان
أوكرانيا اليوم هي كل دولة في العالم مهدَّدة بالغزو والاحتلال لأنها في موقع خاطئ على الخريطة. عندما تجيز أي دولة عظمى لنفسها اجتياح بلد جار، بذرائع ملفّقة، فإنها لا تسحق القانون الدولي بأقدام جنودها فحسب، بل تنتهك في 2022 كل مفهوم حضاري أمكن للبشرية أن تخلقه، وتغلّب الاستحواذ بالقوة على مصائر الشعوب، تكتب انبعاثاً جديداً للدكتاتوريات، وتنشر الخوف وانعدام اليقين والثقة في كل الأرجاء، وأخيراً تسوّغ لأي دولة أصغر منها أن توظّف أحقادها وعقدها التاريخية، وأن تسخّر كل مواردها للتحكّم ببلدان أخرى لديها من تناقضات اجتماعية أكثر مما لديها من ثروات تحرص عليها.
أن تعود الحرب الى أوروبا يعني أن تعود الى العالم، الذي سيتأثّر بشكل أو بآخر، ليس فقط بالأسلحة الموصوفة بالدمار الشامل التي يُرى أثرها، بل أيضاً بالعقوبات التي غدت أسلحة أكثر فتكاً وتتمثّل مفاعيلها بالنّيل من حياة الفرد وكفاحه من أجل حريته وعيشه السويّ.
من الأسئلة التي طُرحت في الأيام الماضية: لماذا يُراد إحياء الاتحاد السوفياتي، وما الذي افتقده العالم فعلاً في غيابه، وهل يستحق إحياؤه أن تغزو روسيا بلداً تعرف أن شعبه يرفضها ويكرهها ولن يتغيّر تجاهها أياً تكن ظروفه؟ ولماذا يجب أن يكون جيران روسيا تحت قدرها وإرهابها أو تحرمهم أبداً من الاستقرار؟ وهل قرار الغزو كان محسوماً لدى الرئيس الروسي فتعمّد طرح مطالب تعجيزية يعرف مسبقاً أن الغرب لن يلبيها، بل لا يستطيع؟
وأيضاً: لماذا لم تبذل دول حلف الأطلسي الجهد الجديّ الضروري لتجنّب الحرب، مع علمها بأنها ستنعكس على اقتصاداتها وحياة شعوبها، وإذا كان بين أهدافها استدراج فلاديمير بوتين الى الخطأ والتورّط، فهل هي واثقة بأنه لن يُقدم بدوره على ارتكاب الفظائع ليستدرجها بدوره الى حروب أخرى في أوروبا؟ وما دامت لا تريد الحرب فلماذا تبرّعت بالإعلان مسبقاً أنها لن تستخدم “الردع” ولن تتدخّل للدفاع عن أوكرانيا، فهل كانت تطمئن بوتين أم ترمي إليه بالطُعم أم تسهّل له المهمة؟ وما دام السلام الدائم سيتطلّب التفاوض في نهاية المطاف فلماذا استسهلت ترك بوتين يعبث بلعبة الحرب بدل أن تحرجه بعروضٍ بديلة؟
الحرب التي ردّدت عواصم الغرب أن “لا داعي لها”، أسفرت الآن عن نتيجة معروفة سلفاً، بل باتت واقعاً ميدانياً، وهي تتمثّل بغلبة قد تكون موقّتة أو دائمة لميزان القوى العسكرية، وبصدام بين قوميّتين: الأولى روسية يراها العالم نيو-سوفياتية يقودها حاكم فرد لإخضاع الغرب وإعادة “الإمبراطورية”، مستوحياً جوزف ستالين الذي غزا أوكرانيا، ومختزلاً في شخصه دكتاتورية الحزب الواحد واستبداد النظام الملكي ما قبل الشيوعي. القومية الأخرى أوكرانية تتوسّل الشعبوية للدفاع عن نفسها في بلد لم يبرأ من أمراضه السوفياتية، لكن بوتين وأعوانه يصوّرونها، تبريراً للغزو، على أنها نيو-نازية تستوحي ممارساتها من الفكر الهتلري، إلا أن هذه الذريعة البروباغندية تبدو مرادفاً لتهمة الإرهاب الجاهزة (تتسلّح بها إسرائيل لتغطية جرائمها ضد الفلسطينيين، ولجأ إليها النظامان الأسدي والإيراني لتبرير القضاء على ثورة الشعب السوري).
قد لا تصحّ المقارنات دائماً، خصوصاً إذا كان اللاعبون والساحات متفاوتي الحجم دولياً، لكن الخبراء العسكريين يقرأون أي حرب ومقدّماتها ومآلاتها وانعكاساتها المحتملة في ضوء التجارب المعروفة. ويذكر في هذا الإطار أن ردود الفعل الأميركية المسبقة ربما صوّرت للرئيس العراقي السابق صدّام حسين عام 1990 أنه يمكنه أن يغزو الكويت ويحتلّها من دون أن يتعرّض لأزمة كبرى ترتدّ على نظامه وعلى العراق، لذلك قيل له إنه أخطأ في حساباته، إذ هُزم وطُرد من الكويت، وكُبّل العراق بعقوبات قاسية مهّدت لغزوه واحتلاله (2003) ولم يخرج من تحت البند السابع الأممي إلا قبل أيام، لكن في الأثناء كانت أسوأ النتائج قد عصفت بالعالم العربي وأضعفته ثم أدخلته في خواء استراتيجي مستمر.
عدا التشابهات الشخصية والعقلية بين الاستبداديين، قد يكون التفصيل الوحيد الذي يصحّ استرجاعه حالياً هو أن الرئيس الروسي استخلص من المواقف الملتبسة، الأميركية والأطلسية، أنها تشجّعه على اجتياح أوكرانيا، ولو جزئياً (الاكتفاء بالـ”جمهوريتين” الانفصاليتين، مثلاً)، ما دام “الناتو” وواشنطن كرّرا علناً أنهما لن يتدخّلا، أما العقوبات التي تُفرض على روسيا فتنمّ في نظره عن “ضعف” غربي وستكون أيضاً موجعة للاقتصادات الغربية. غير أن الاختلاف الكبير هو أن روسيا دولة كبرى لا تشبه سوى دول بحجمها وقدراتها، وأن بوتين لا يزال يرى مسألة أمن روسيا بمنظار سوفياتي أكبر وأوسع من إقليم دونباس الأوكراني.
يريد بوتين كل أوكرانيا ليجعل منها “دولة محايدة منزوعة السلاح”، وبالتالي دولة فاصلة عن منطقة نفوذ “الناتو”، لكن وجودها تحت سيطرته الكاملة يعني أنه يرمي الى استخدامها لابتزاز “الناتو” وتهديد أعضائه من الدول الأوروبية (السوفياتية سابقاً). لم يرَ بوتين أن الترابط الواسع لمصالح روسيا الاقتصادية والمالية، الذي نشأ طوال العقود الثلاثة الماضية مع الدول الغربية، يفترض استراتيجية تعايش، بل ظل يهجس بمعادلات القوة، وهذه ليست فقط عسكرية ولا يمكن أن تكون لمصلحته.
من الواضح أن الدول الغربية فرضت تلك العقوبات على مضض، لكنها اعتبرتها “تضحية” لا بدّ منها، وتبقى أقلّ تكلفة من الانخراط في مواجهة حربية مباشرة. هذا لا يبدّد مناخ الحرب الذي سينعكس عليها كدول (تضخّم ميزانيات الدفاع) وعلى شعوبها المطلوب منها أن تتحمّل الأكلاف. أما أوكرانيا التي جعلها قدرها “دولة تماس” فلن تعود الى ما كانت عليه قبل 2014، ولا حتى قبل 24 شباط (فبراير) 2022، إذ دخلت نفقاً طويلاً مظلماً، وأمامها سيناريوان متداخلان يطيلان أمد الحرب. أولهما الرزوح تحت نير الاحتلال الروسي، بما يعنيه من استسلام جيشها وتفكيكه وإقامة حكم موال لموسكو، وإجراء جراحة شاملة لـ”تطهير” الدولة العميقة من القوميين الأوكرانيين، لكن ذلك يتطلّب وجوداً روسياً دائماً ومكلفاً وليس فقط الاعتماد على روس أوكرانيا. أما السيناريو الآخر فهو المقاومة وحرب العصابات المفتوحة، وهناك مؤشرات الى أن عناصرها وأسلحتها موجودة، وأن خططها مدروسة مسبقاً. ويبدو أن “الناتو” يراهن على هذه المقاومة كخيار استنزافي سبق أن جُرّب في أفغانستان وألحق هزيمة بالقوات السوفياتية.
النهار العربي
——————————-

كيف نجحت «حرب بوتين» في تغيير عقيدة برلين العسكرية؟
100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني
برلين: راغدة بهنام
خلال أيام قليلة، نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دفع ألمانيا لتحقيق ما قضى رؤساء أميركيون سنوات يحاولون إقناعها به، من دون نجاح. وفي لحظة لن تكون عابرة، وقف المستشار الألماني أولاف شولتس أمام البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعلن أن ألمانيا ستبدأ بإنفاق 2 في المائة من ناتجها الإجمالي على الأقل، على أمنها الدفاعي، رداً على التصعيد العسكري الروسي على أبواب أوروبا. إذ أنفقت ألمانيا العام الماضي 1.4 في المائة من ناتجها القومي على الأمن الدفاعي، ما يعني أن نسبة الإنفاق ستزيد 0.6 في المائة، ما يترجم إلى إضافة سنوية بنحو 20 مليار يورو.
وأكثر من ذلك، فقد أعلن شولتس أن برلين ستخصص من ميزانية العام الحالي 100 مليار يورو للدفاع لإعادة تسليح الجيش الهرم، وتزويده بمعدات متطورة وصيانة معداته الموجودة.
وسيجعل هذا الإعلان ألمانيا من بين الدول الأوروبية الأكبر في إنفاقها العسكري، بسبب حجم اقتصادها الأكبر أوروبياً. وهذا تحديداً، ما كانت ألمانيا تحاول تجنبه لسنوات متحجّجة بتاريخها. لكن الحرب على أوكرانيا، قال شولتس، وتاريخ 24 فبراير (شباط) يوم بدء العملية الروسية العسكرية: «هو نقطة تحول في تاريخ القارة الأوروبية». ومن المفترض أن يصوّت البرلمان على مشروع قانون يسطر زيادة الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة، كي يجبر الحكومات المقبلة على الالتزام به.
وبرّر شولتس إعلان زيادة الإنفاق العسكري الضخم بـ«المسؤولية التاريخية» الملقاة على كاهل أوروبا لمنع توسع الحرب، ووقف بوتين عن «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وقال للنواب المصفقين: «بوتين يعرّض أمن أوروبا للخطر… ومن الواضح أننا يجب أن نستثمر بشكل أكبر بكثير في أمننا بهدف حماية حريتنا وديمقراطيتنا». وأعلن شولتس أيضاً أن ألمانيا ملتزمة بحماية الدول المنتمية لـ«الناتو»، وبأنها لذلك ستعزز انتشارها ومساعداتها العسكرية ضمن قوات الناتو في الدول الأوروبية الشرقية.
ويأتي الإعلان المفاجئ بعد يوم على إعلان حكومة شولتس قراراً تاريخياً آخر، يعكس سياسات اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لسنوات وتمسكت بها، عندما أعلن أن بلاده سترسل أسلحة إلى أوكرانيا بشكل مباشر، من بينها صواريخ ستيغر المضادة للطائرات. وحتى قبل أيام قليلة كانت برلين ترفض إرسال أسلحة لكييف، وتؤكد أنها لن تغير سياستها التي تقضي بعدم إرسال أسلحة لمناطق النزاعات، متحججة أيضاً بتاريخها.
وحرصت الحكومات الألمانية المتعاقبة على إبقاء الجيش الألماني ضعيفاً عمداً، مسلحاً بالحد الأدنى وغير قادر على خوض حروب تقليدية. واكتفت برلين حتى اليوم بتقديم مساعدات تدريب، وإرسال معدات تكنولوجية عسكرية ضمن الناتو للدول التي تتنشر فيها قوات الحلف مثل أفغانستان. وفيما كانت أوروبا حتى الأمس تتخوف من جيش ألماني قوي، فإن زيادة الإنفاق العسكري في ألمانيا أصبح مطلباً أوروبياً في الأيام الماضية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد.
وتطرّق شولتس إلى قرار تسليح أوكرانيا في كلمته أمام البرلمان، وبرر القرار بالقول إن حكومته «لم تكن أمام خيار آخر أمام تهديدات بوتين». وحذر من أن الرئيس الروسي «يهدف إلى إعادة الإمبراطورية الروسية» من خلال القوة. وأضاف أن قرار ألمانيا دعم الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي الروسي واستبعاد مصارف روسية من نظام سويفت، قد يتوسع لكي يشمل عقوبات «من دون حدود».
ويقصد شولتس بذلك استعداد بلاده لفرض عقوبات على الغاز الروسي الذي تعتمد ألمانيا بثلث طاقتها تقريباً عليه. وكان المستشار الألماني قد أعلن بعد يوم على بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا، وقف العمل بمشروع «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، لكنه لم يبدأ العمل بعد. وقال إن المشروع أصبح يشكل «تهديداً للأمن القومي» في ألمانيا. وكان قرار شولتس لافتاً، خاصة أن ألمانيا ظلت متمسكة بالمشروع لسنوات، وتدافع عنه على أنه اقتصادي، ولن يسمح لروسيا بأن تزيد تأثيرها عليها. ومما أعلنه شولتس أمام البرلمان أيضاً خطط تعمل عليها الحكومة لبدء تقليص اعتمادها على الغاز الروسي الذي يصلها حالياً عبر أنابيب المرور في أوكرانيا، وقال إن البلاد ستزيد من احتياطي الغاز في المستقبل القريب، وستبني محطتين إضافيتين لذلك في أسرع وقت ممكن، فيما ستسرع بالعمل على مشروعات الطاقة المتجددة.
وبقيت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل متمسكة بالمشروع، حتى بعد أن فرضت إدارة دونالد ترمب السابقة عقوبات عليه للضغط على برلين لوقفه. حتى شولتس نفسه بقي متمسكاً بالمشروع ويدافع عنه حتى اليوم الأخير لبدء العملية العسكرية الروسية. لكن حزبي الخضر والليبرالي، اللذين يشاركان في الحكومة الائتلافية لعبا دوراً في إقناع شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي، بالتخلي عن المشروع والانضمام للدول الغربية في تشديد العقوبات على روسيا.
وحزب الخضر، الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، كان دائماً يروج لسياسة أكثر تشدداً مع روسيا، حتى قبل دخوله السلطة. كما أن رئيس حزب الليبراليين كريستيان ليندر الذي أصبح وزيراً للمالية في حكومة شولتس، هو صديق شخصي للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وقضى أسابيع إلى جانبه عندما أجلي إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم في روسيا، وهو أيضاً كان ينادي للتشدد مع روسيا قبل بدء الحرب على أوكرانيا.
في المقابل، لطالما كان الحزب الاشتراكي من رواد سياسة الانفتاح على روسيا، والمستشار السابق غيرهارد شرودر ما زال يجلس في مجلس إدارة مشروع «نورد ستريم 2»، وهو كان لسنوات من أكبر مروجي العلاقة المقربة مع روسيا. وشرودر صديق شخصي للرئيس الألماني فرانك فالتز شتاينماير، الذي كان له تأثير أيضاً على ميركل التي طبّقت سياسة التقارب مع روسيا طوال فترة حكمها الذي استمر 15 عاماً.
ولم يعترض على قرارات شولتس التي أعلنها أمام البودنستاغ إلا حزبا اليمين المتطرف «البديل لألمانيا» واليسار المتطرف «دي لينكا»، اللذان يحظيان سوياً بـ119 مقعداً من أصل 736 مقعداً في البرلمان. والحزبان لديهما علاقات خاصة بروسيا، الأول يحظى نوابه بدعم من موسكو، والثاني «دي لينكا» لجذوره الشيوعية أيام الوجود السوفياتي في ألمانيا.
الشرق الأوسط
——————————-
الصين كمنتصرة في حرب لا تخوضها/ مهند الحاج علي
ما زالت ارتدادات عزو أوكرانيا على مستوى العالم تظهر تباعاً، نظراً لأهمية هذه الحرب، جغرافياً وسياسياً، ووقعها مستقبلاً على قضايا أخرى، ومنها تلك البعيدة جغرافياً. اليوم، بالإمكان تحديد ثلاثة انعكاسات أولية.
بداية، ستُنتج هذه الحرب عالماً أكثر تسلحاً، بدءاً من أوروبا. كان لافتاً رد الفعل الأوروبي، إن لجهة تزويد أوكرانيا بالسلاح من أجل مقاومة الغزو الروسي، أو لناحية رفع مستوى الانفاق الحربي في البلدان الأعضاء.
على سبيل المثال لا الحصر، ألمانيا اتخذت قراراً تاريخياً في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والآليات، رغم أنها اليوم منطقة نزاع. هذا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أن سياسة برلين ثابتة حيال تجنب توفير الدعم العسكري خلال نزاع.
وهذا الموقف الألماني الجديد ينمّ عن “تحول كبير” في السياستين الخارجية والدفاعية على وقع الحرب، كما جاء في كلمة المستشار الألماني أولاف شولتس يوم أمس. “مع غزو أوكرانيا، أصبحنا في حقبة جديدة”، قال شولتس، ولهذا رفع الموازنة العسكرية بقيمة مئة مليار يورو لتعزيز قدرات الجيش الألماني.
ستستثمر ألمانيا “من الآن وصاعداً، وعاماً بعد عام، أكثر من اثنين في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في قطاعنا الدفاعي”، بحسب شولتس، بهدف ضمان نمو القوة العسكرية الألمانية والصناعات والابتكارات الحربية بالبلاد.
وهذا لن يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سيشمل على الأغلب معظم الدول الأوروبية القلقة من مفاعيل غزو أوكرانيا وما يعنيه على مستوى العلاقات الدولية. ذاك أن هذه الدول كانت تُفضل الاستثمار في بنيتها التحتية واقتصادها، وتغليب النمو على الانفاق في المجال العسكري، مع الاعتماد على حلف الناتو والولايات المتحدة لتوفير الأمن.
مثل هذا الانفاق أحد أبرز انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا، وسيستمر بعدها ليطبع الحياة العامة الأوروبية وسط تضخم لجيوشها وقدراتها العسكرية، استعداداً لمواجهة محتملة.
الانعكاس الثاني، اقتصادي، وعلى ارتباط بنتائج الغزو. روسيا ستصير معزولة دولياً على المستوى المالي والاقتصادي، وعليها البحث عن منافذ للتهرب من العقوبات، أكان عبر الصين أو إيران أو شبكات الجريمة. وهذه السياسة الغربية ستزيد من مستوى الاستقطاب والفرز، وستُحول كل مواجهة مع موسكو الى معركة وجودية مع نظام الرئيس فلاديمير بوتين. محاولة الخنق مالياً واقتصادياً لن تنحصر في هذا المجال، كما رأينا مع إيران التي زعزعت استقرار الخليج العربي ومبيعات النفط منه. لماذا علينا توقع سلوك روسي مغاير لذلك الايراني بعد عقوبات غزو أوكرانيا؟ بالتأكيد ستلجأ روسيا للتنمّر والتخريب كلما اتسعت ورطتها الاقتصادية.
ثالثاً، منطقة جنوب شرقي آسيا ستزداد توتراً ليس فقط نتيجة المخاوف المتصاعدة في جزيرة تايوان، وهي أكثر عرضة كونها سيادياً خاضعة للجانب الصيني (لا اعترافاً دولياً بتايوان)، بل كذلك نتيجة التوتر بين روسيا واليابان. هذان بلدان لديهما نزاع حدودي، مع سيطرة الاتحاد السوفييتي غداة الحرب العالمية الثانية على أربع جزر شمال جزيرة هوكايدو اليابانية (اسمها في اليابان “المناطق الشمالية” وفي روسيا “جزر كوريل الجنوبية”).
اليابان انضمت لقطار العقوبات على روسيا، وهذا من شأنه مفاقمة التوتر معها في آسيا كذلك (روسيا قوة آسيوية وأجرت مناورات مشتركة مع الصين قرب اليابان). استراتيجياً، على الولايات المتحدة اليوم زيادة تركيزها على أوروبا وحلفائها في القارة، لردع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، لكن ذلك قد يعني، ولو مرحلياً، إعادة النظر في سلم أولويات إدارة الرئيس جو بايدن بالسياسة الخارجية، وتحديداً احتواء الصين. قد يتطلب ردع بوتين تعاوناً مع الصين، تماماً كما تحتاج واشنطن الى بكين لانجاح مفاوضات فيينا.
يبقى أن الحرب الأوكرانية ورغم أنها تدور على بُعد آلاف الكيلومترات من الصين، وعلى أراضي قارة أخرى، إلا أن اسم بكين لا ينفك يبرز في كل تحليل عن المستفيدين. وفي حال التفاوض، قد تكون الوسيط الأكثر فاعلية.
المدن
——————————-
كيف ينعكس غزو أوكرانيا على معيشة السوريين؟/ إياد الجعفري
بدأت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تتجلى سلباً على حساب معيشة السوريين، عبر مؤشرٍ بات منذ سنوات أشبه بـ ” تِرْمُومِتْر” حسّاس ينبئ دوماً باتجاهات الوضع الاقتصادي. ونقصد هنا، سعر الصرف.
فحتى قبل بدء الغزو، رسمياً، فجر الخميس، بدأت الليرة السورية تترنح، وتحديداً، منذ يوم الثلاثاء، لتخسر خلال خمسة أيام، 1.5% من قيمتها، مع إغلاق تعاملات مساء السبت.
للوهلة الأولى، تبدو نسبة تراجع سعر الصرف، متواضعة، مقارنةً بتقلبات الليرة في تجارب سابقة. لكن بالعودة إلى تحركات سعر الصرف خلال الشهرين السابقين، يتضح لدينا، أن الليرة بقيت مستقرة ضمن هامش تذبذب لا يتجاوز الـ 1.5% من قيمتها. أي أن الليرة السورية خسرت خلال 5 أيام، ما سبق أن خسرته قبل ذلك، في شهرين. أما المؤشر الأبرز فهو أن الليرة أغلقت مساء السبت عند أدنى سعر مبيع لها مقابل الدولار في دمشق، منذ نحو 11 شهراً. أي أن الليرة السورية تراجعت إلى أدنى سعر لها منذ نحو عامٍ، بدفعٍ من التداعيات الاقتصادية الأولية للغزو الروسي لأوكرانيا. وهي تداعيات من المرجح أن تتفاقم خلال الشهرين القادمين.
حكومة النظام استنفرت خلال الأيام الثلاثة الأولى للغزو. وكأنها وجدت ما تتلقفه لتبرير تدهور معيشي جديد ينتظر السوريين. وأصدرت بيانات وتصريحات حملت عناوين عريضة، مفادها، التقشف والترشيد والتقنين وشد الأحزمة، والمزيد من المستبعدين من الدعم الحكومي.
وبعيداً عن الثقة المفقودة بين السوريين و”حكومتهم”، كان يمكن تفهم كل الأسباب التي ساقتها الحكومة لتبرير إجراءات ستزيد من قسوة الحياة على السوريين في الفترة المقبلة، بوصفها نتيجة لا يمكن الفِكاك منها، جراء حرب تحمل أبعاداً وتداعيات اقتصادية دولية، من ارتفاع لأسعار النفط والغاز والقمح وتضاعف تكاليف النقل الدولي، وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء. كان يمكن تفهم كل تلك المبررات، لولا أن الشفافية في تصريحات المسؤولين، وفي إجراءاتهم، ما تزال مفقودة. ناهيك عن شبهات الفساد وهدر المال العام، وسوء إدارة الموارد الشحيحة المتاحة.
كأحد الأمثلة على فقدان الشفافية، تهرّب وزير الاقتصاد من الإفصاح عن كفاية مخزون القمح في البلاد، رغم أن السؤال وُجّه إليه من صحيفة مقرّبة –الوطن-. فهل الإفصاح عن كفاية مخزون القمح في سوريا، “سرّ حربيّ”؟ أم أن لذلك “السرّ” قيمة خاصة لدى وزراء الحكومة؟
يحيلنا التساؤل الأخير إلى اتهامٍ خطيرٍ وجّهه ناشط موالٍ لوزير التجارة الداخلية، بالتورط في تمرير قمح مدعوم لصالح تاجرٍ مقرّب من مدير عام مؤسسة الحبوب الذي يتمتع بصداقة شخصية مع الوزير. بطبيعة الحال، لا يمكن الجزم بمصداقية هذا الاتهام، إذ قد يندرج في إطار صراعات المحاور والفاسدين داخل أروقة مؤسسات الحكومة والأجهزة الأمنية، خاصة أن الوزير الذي ردّ على منشور الاتهام، وصف الناشط الذي كتبه بـ “الوطني”، مما يؤشر إلى أن الناشط يحظى بغطاء من جهة أمنية ما. لكن ذلك يمثّل دليلاً آخر، على حالة الفساد والهدر التي تنال من الموارد الشحيحة المتاحة لدى حكومة النظام، والتي لا تصل جميعها إلى الفئات المستحقة، بخلاف مزاعم المسؤولين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، عدم استلام كثيرٍ من السوريين المستحقين لمخصصاتهم من المشتقات النفطية خلال العام الفائت. وتأخر رسائل تسليم أنبوبات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية.
ومن الأمثلة عن الإجراءات غير الشفافة لحكومة النظام، والمثيرة للريبة حول أهدافها الحقيقية، قرار مصرف سورية المركزي السماح بتسليم الحوالات الخارجية التي تتجاوز قيمتها الـ 5000 دولار، بالعملة الصعبة. فيما لا يجوز ذلك للحوالات التي تقل قيمتها عن هذا السقف.
ومن المعلوم، أن معظم الحوالات التي يتلقاها حوالي ثُلثَي السوريين، تتراوح بين 100 و400 دولار. وهذه الحوالات تشكل مصدر المعيشة الأساسي لفئة ساحقة من السوريين اليوم. ويفرض المركزي على هؤلاء تسلم تلك الحوالات بالليرة السورية بسعر صرف 2500 للدولار الواحد، فيما سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز الـ 3680 ليرة للدولار، أي أن المركزي يجعل غالبية السوريين يخسرون أكثر من ثُلث قِيَم حوالاتهم، فيما سيُتيح لمن يتلقى حوالات كبيرة، تتجاوز الـ 5000 دولار، أن يحصل عليها، بالعملة الصعبة، دون أية خسارة من قيمتها. والفئة المستفيدة من هذا القرار، هي رجال الأعمال والصناعيين والتجار. هذه الفئة ذاتها، التي سارعت لرفع أسعار منتجاتها على السوريين، بعيد قرار رفع الدعم عن 600 ألف أسرة، مؤخراً. وهي الفئة التي تسارع الآن لرفع الأسعار، بعد أن منحتها حكومة النظام المبرر الكافي لذلك، حينما تحدثت عن ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، جراء غزو أوكرانيا.
وعلى سبيل الكوميديا السوداء، وفيما رفعت حكومة النظام تكاليف كل السلع التي تحتكرها وتقدمها للسوريين، قبل حتى الأزمة الأوكرانية، وتتوعد السوريين بإجراءات أقسى، بعدها.. يأتي تصريح وزير الاقتصاد ليقول أنه لا حجة للتجار السوريين برفع الأسعار، جراء الأزمة ذاتها، في سياقٍ مثير للسخرية. خاصةً أن الأسعار بدأت ترتفع بالفعل، خلال الأيام الثلاثة الأولى للغزو. والقادم أشد سوءاً.
فما ينتظر السوريين في الشهرين القادمين، سيبدأ بزيادة ساعات تقنين الكهرباء، التي كان سكان دمشق، قبل بدء الأزمة الأوكرانية، لا يرونها إلا ساعة واحدة مقابل ست ساعات قطع، فيما كانت تغيب بشكل شبه كامل عن بعض مدن الريف الدمشقي. كما وينتظر السوريين لهيب أسعارٍ جديدٍ، يزيد من استعار لهيب الأسعار السابق جراء قرارات رفع الدعم، دون أن ننسى خفضاً مرتقباً جديداً لكميات المشتقات النفطية المتاحة. والأخطر من ذلك، انهيار نوعي لسعر الصرف، خاصة إن طال أمد الأزمة في أوكرانيا، وتصاعدت تداعياتها الاقتصادية الدولية.
المدن
————————————-
ايران ودروس اوكرانيا الاقليمية/ حسن فحص
على الرغم من سياسة “الحياد الإيجابي” الذي اعتمده النظام الإيراني في التعامل بداية مع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان عام 2001، ولاحقا مع احتلال العراق 2003، إلا أنه وفي لحظة تاريخية مفصلية، وجد نفسه محاصرا بين فكي كماشة امريكية بعديد جنود يتجاوز الثلاثمائة ألف مقاتل بكامل تجهيزاتهم البرية والجوية والبحرية، منتشرين على حدوده الشرقية والغربية – الجنوبية. ما رفع مخاطر استهدافه، خاصة بعد ان عمد الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش إلى التنكر للمساعدة الايرانية، واعلن وضع النظام في دول محور الشر.
هذه المخاوف، تضاف لها أزمة انكشاف انشطته النووية التي بقيت حتى ذلك التاريخ تجري في سرية وبعيدا عن أنظار المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية المعنية بهذه الانشطة، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، دفعت النظام لاعادة ترتيب اولويات في التعامل مع الحقائق المستجدة في محيطه الحيوي، أو ما يعرف في الأدبيات الايرانية والامريكية بمنطقة غرب آسيا، معتمدا على تجميع اوراقه الاقليمية وتوظيفها في إطار استراتيجية تحقق له وتساعده على تفكيك وكسر الطوق الذي بدأ يضيق حول مصالحه ودوره وحتى استمراريته.
هذه الاستراتيجية الجديدة، سمحت للنظام في طهران بتحويل المنطقة الى مستنقع حقيقي امام الوجود الامريكي، وإلهائه واشغاله بالجماعات الرافضة للاحتلال تحت عناوين مختلفة. بحيث سمحت لامين المجلس الاعلى للامن القومي حينها علي لاريجاني لتقديم نصيحة للادارة الامريكية بضرورة الانسحاب من العراق وافغانستان، شرط التنسيق مع ايران، حتى لا تدخل في مستنقع الفوضى والاستهداف. فضلا عن ان الرئيس الايراني عام 2004 محمد خاتمي اعلن استعداد بلاده لمساعدة واشنطن لتأمين انسحاب مشرف من العراق.
من ناحية اخرى، وفي البعد الاخر لهذه الاستراتيجية، وظفت ايران جهود مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا) التفاوضية حول الملف النووي، لتأكيد مخاوفها من الانتشار الامريكي في منطقة غرب آسيا، وما يشكله من تهديد لامنها واستقرارها، خاصة وان الادارة الامريكية لم تدخل اي تعديل على عقيدتها تجاه النظام والعمل على تغييره، لذلك حاولت استغلال الحاجة الدولية لوقف البرنامج النووي من اجل الحصول على ضمانات امنية، فضلا عن تكريس رؤيتها ومطلبها بعدم تحويل المنطقة الى ساحة عمل ونفوذ لقوات حلف الناتو في حال قررت الولايات المتحدة الامريكية الانسحاب من المنطقة.
في المقابل، سعت ايران لاعادة انتاج مفهومها للامن القومي، من خلال احياء الرؤية التي بدأت بالتبلور في العهد الملكي في ما يتعلق بالدور الجيوسياسي لايران في محطيها، وكيفية تعزيز دورها الممسك بامن المنطقة من خلال التفويض الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة الامريكية ك”شرطي الخليج”. وعملت على تعزيز قدراتها وتوسيع نفوذها في المنطقة من خلال دعم حلفائها ودفعهم للامساك بزمام المبادرة والقرار سواء في العراق ولبنان وفلسطين، ومؤخرا سوريا واليمن، من دون اهمال مصالحها باتجاه اسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية من البوابة الافغانية. الامر الذي سمح لها بطرح رؤيتها الجديدة حول الامن الاقليمي، ورفض اي وجود عسكري أجنبي سواء امريكي مباشر او غير مباشر عبر الناتو في هذه المنطقة، خاصة الخليج. على مبدأ ان دول المنطقة قادرة على توفير الامن واقامة منظومة دفاع وأمن خاصة بها من دون الحاجة لوجود قوات اجنبية وغربية فيها، وقد وضعت هذه الرؤية مبكرا على طاولة التفاوض امام “سولانا” في تشرين الاول اكتوبر 2004 بالتزامن مع الاعلان عن اول اتفاق مع الترويكا الاوروبية حول تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
النظام الايراني لم يتخل عن رؤيته الاستراتيجية هذه المتعلقة بامن منطقة الخليج وبناء منظومة امنية بمحورية ايران وقيادتها التي تعتمد على ما حققته من دور ونفوذ وتقدم عسكري يجعلها غير محتاجة لمظلة امريكية لفرض هذه الاستراتيجية، الا انها كانت في المقابل، بحاجة الى قبول وموافقة دول المنطقة، خاصة الخليجية على ذلك، في وقت كانت هذه الدول تقع تحت وطأة الخوف من هذا الدور المتنامي والنفوذ الايراني الذي تصفه بالمزعزع لامنها الداخلي واستقرارها. الامر الذي جعلها تتعامل مع اي طرح او مشروع ايران، ومؤخرا مع مشروع “امن هرمز” الذي حاول الرئيس السابق حسن روحاني الترويج له من ضمن رؤيته الاستراتيجية لبناء “منطقة قوية” بالكثير من الحذر، خاصة بعد تداعيات الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما عام 2015 والذي اطلق يد ايران في المنطقة بغض نظر امريكية على حساب مصالح دول المنطقة وامنها واستقرارها.
في الايام الاخيرة، وعلى هامش قمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز ” GECF” الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة عشية الغزو الروسي لاوكرانيا، اعاد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي المشارك في هذه القمة الحديث عن بناء منظومة امنية اقليمية من دول المنطقة، لا يكون لامريكا ودول حلف الناتو اي دور فيها.
مع تصاعد الازمة الاوكرانية، وبانتظار تبلور الصورة بشكل اكثر وضوحا، خاصة ما يتعلق بتردد دول حلف الناتو، حد العجز- في التدخل لصالح كييف ومواجهة الغزو الروسي، والذي ترك اوكرانيا وحيدة في مواجهة الاستراتيجية موسكو للامن القومي والمجال الحيوي. يجلس النظام الايراني بانتظار ان تكتمل الرؤية عند دول المنطقة بضرورة الذهاب الى تفاهمات اقليمية بعيدا عن المنظومة الامريكية والغربية التي كشفت التجارب الاخيرة من افغانستان وصولا الى اوكرانيا بانها غير قادرة على توفير الامن لاي من الدول الحليفة لها “حتى استراتيجيا” من خارج حلف الناتو او من داخله. ما يساعد على الدفع برؤيتها لاقناع هذه الدول في بناء منظومة امنية خاصة بقدرات ذاتية من دول المنطقة بعيدا عن وجود اي قوة اجنبية عاجزة عن تأمين وتوفير امنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها الحيوية والاستراتيجية.
———————-
العملية العسكرية الخاصة… مشهد من موسكو/ فلاديمير إيفسييف
في 24 فبراير (شباط)، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. كان السبب للتطور، المناشدة التي قدمها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بطلب المساعدة في صدّ عدوان القوات المسلحة الأوكرانية المتواصل.
أعلن بوتين على الفور أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح من أوكرانيا، فضلاً عن تقديم أولئك الذين ارتكبوا كثيراً من «الجرائم الدموية ضد مدنيين، بينهم مواطنو الاتحاد الروسي» إلى العدالة.
من وجهة النظر الروسية، فإن تحرك القوات المسلحة مشروع. وفي اليوم السابق، اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ووقّع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع رئيسيهما. وقد مرت هذه المعاهدات بعملية التصديق في مجلسي الدوما والشيوخ. وتم منح الرئيس الإذن من مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بإرسال القوات المسلحة إلى منطقة النزاع.
في الغرب، اعتُبر قرار بوتين بمثابة عدوان من جانب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا المستقلة. على الرغم من أن القوات المسلحة لأوكرانيا كانت حتى وقت قريب تستعد لحل عسكري في دونباس. ونشرت نحو 150 ألف عسكري هناك (نحو 70 في المائة من قوة الجيش الأوكراني)، من دون احتساب عناصر المجموعات المسلحة التي تشكلها كتائب القوميين.
من غير المحتمل للغاية أن تكون الأغراض الدفاعية وحدها، دفعت القوات المسلحة الأوكرانية إلى زج 450 دبابة وزرع ألغام في قطاعات واسعة على خط المواجهة.
في وقت سابق، دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها (أولاً وقبل كل شيء، بريطانيا العظمى وتركيا وبولندا ودول البلطيق) بكل طريقة ممكنة قيادة كييف لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في دونباس. وهذه الأطراف لم تكتفِ بتشجيع كييف عبر الدعم السياسي وحده، بل قامت بتزويدها بطرازات مختلفة من الأسلحة والذخيرة الحديثة، كما أرسلت إلى أوكرانيا مدربين ومستشارين.
كانت روسيا قلقة للغاية بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وما يمكن أن تلي ذلك من تدابير لنشر قواعد عسكرية أميركية على أراضي أوكرانيا. فضلاً عن أن هذا تزامن مع رفض واشنطن الكامل، مناقشة الضمانات الأمنية مع موسكو على أساس مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة. علاوة على ذلك، في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أنه سيبدأ العمل لعقد اجتماع للدول المشاركة في مذكرة بودابست (1994) من أجل مراجعة قرار تخلي أوكرانيا عن وضعها كقوة نووية.
إن الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة في أوكرانيا، يمكن أن تسمح لكييف ليس فقط بتطوير أسلحة نووية في وقت قياسي، ولكن أيضاً لإنشاء وسائل حديثة لإيصالها باستخدام الصواريخ الباليستية. هذا، إلى جانب حقيقة وقوع كارثة إنسانية في دونباس؛ حيث يعيش ما لا يقل عن 700 ألف من مواطني الاتحاد الروسي، دفع الرئيس بوتين إلى اتخاذ قراره بإطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
مع انقضاء اليوم الثالث للعملية، كان الجيش الروسي قد دمر 975 منشأة تابعة للبنى التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 23 مركزاً للقيادة والاتصالات للقوات المسلحة و31 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طرازات «إس 300» و«بوك» و«أوسا» و48 محطة رادار. وأسقط الجنود الروس 8 طائرات مقاتلة و7 طائرات هليكوبتر و11 طائرة من دون طيار، ودمّروا صاروخين تكتيكيين لمجمع من طراز «توتشكا». كما تم تدمير 223 دبابة ومدرعات أخرى، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة مدفعية ميدانية من طراز «هاون»، و143 مركبة عسكرية على الأرض.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تقدمت الكتائب الشعبية في لوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، إلى عمق 52 كيلومتراً وسيطرت على 7 مدن وبلدات جديدة. وتقدمت قوات دونيتسك نحو 10 كيلومترات أخرى في اتجاه بتروفسكوي واستولت على 3 بلدات جديدة. كما تقدمت القوات إلى مدينة ماريوبول من الشمال وتدريجياً من الشرق، برغم قيام الكتائب القومية الأوكرانية المنسحبة بتفجير المحطات الكهربائية الفرعية والجسور عبر الأنهار.
أيضاً، تقدمت مجموعة القرم التابعة للقوات المسلحة الروسية من الجنوب؛ خصوصاً على طول بحر آزوف. وبدا واضحاً أن الهدف يتمثل في تطويق القوات الأوكرانية في دونباس من الجنوب والغرب.
من المهم بشكل أساسي أن القوات المسلحة الروسية لا تسعى إلى اقتحام المدن الأوكرانية الكبيرة، بل تحاصرها فقط. في الوقت الحاضر، تم تنفيذ ذلك فيما يتعلق بخيرسون وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وكونوتوب وبيرديانسك، وجزئياً فيما يتعلق بكييف. يتم ذلك لتقليل عدد الضحايا بين المدنيين والحفاظ على البنية التحتية. من ناحية أخرى، تعمد القوات المسلحة الأوكرانية إلى نشر المدفعية في المناطق السكنية في المدن، وتوزيع الأسلحة على نطاق واسع ومن دون رقابة. وقد أدى هذا التصرف إلى انتشار أعمال قطع الطرق ونهب المحلات التجارية في كييف. هناك معطيات عن وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والكتائب القومية.
يتجلى ميل الجانب الروسي إلى السلام في حقيقة أنه بعد ظهر يوم 25 فبراير، انتظاراً لاحتمال إطلاق مفاوضات مع القيادة الأوكرانية، تم تعليق تقدم القوات الرئيسية للقوات الروسية. ومع ذلك، في اليوم التالي تم استئناف العمليات الخاصة في أوكرانيا بسبب رفض كييف للتفاوض. كان من المفترض إجراء هذه المفاوضات في مينسك، وتم تشكيل الوفد الروسي لهذا الغرض. وفي البداية، عرض الجانب الأوكراني إجراء محادثات في وارسو. ولكن بعد ذلك، بناءً على نصيحة من رعاتهم الأميركيين، تراجع الأوكرانيون عن المشاركة في محادثات.
في الأثناء، واصل الغرب وأوكرانيا إطلاق العنان لحرب إعلامية ضد روسيا. في هذا الإطار، يكفي لفت الأنظار إلى حدث وقع في 26 فبراير عندما استسلم 82 من حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان، وتم نقلهم إلى سيفاستوبول. في وقت قالت فيه سلطات كييف إن الجنود الروس أطلقوا النار عليهم، بل تم منحهم جميعاً لقب أبطال أوكرانيا.
وأثناء إجلاء الأسرى الأوكرانيين، حاول 16 قارباً من القوات البحرية باستخدام «تكتيكات السرب» مهاجمة السفن الروسية التي تنقل الأسرى، كان الغرض واضحاً؛ تأكيد كذب رواية أعداد المجموعة. واللافت أنه تم تنسيق تحرك الزوارق الأوكرانية من قبل الطائرات الاستراتيجية الأميركية من دون التي قامت في ذلك الوقت بطلعات في المنطقة، ونقلت معطيات عن تحرك السفن الروسية إلى الجانب الأوكراني المهاجم.
في هذا الإطار، علينا التذكير بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وأركان قيادته تركوا كييف تحت رحمة القدر. هم الآن في لفيف (توضيح من «الشرق الأوسط»: بعد تلقي المقال، أكّدت الرئاسة الأوكرانية وجود زيلينسكي وأفراد من حكومته في كييف، ونشروا مقطعاً مصوراً له في شوارعها).
على ما يبدو، في إطار العملية الخاصة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، هناك مستويان للأهداف الموضوعة. الأول هو هدف «الحد الأدنى» من المهمة، ويتركز في فصل أوكرانيا عن مناطق «روسيا الجديدة» التي يغلب على سكانها الناطقون بالروسية (تم انتهاك حقوقهم المدنية باستمرار). وضمن هذه المناطق، تقع دونيتسك ولوغانسك وخرسون ونيكولاييف وأوديسا وزابوروجي ودنيبروبتروفسك وخاركوف. فضلاً عن مدينة كييف. في هذه الحالة، تفقد أوكرانيا عملياً إمكاناتها الصناعية وجزءاً كبيراً من السكان.
بهذه الطريقة، أوكرانيا سوف تغدو أقل خطورة بكثير بالنسبة إلى روسيا، لكن التهديد الناتج عنها سوف يعود إلى الازدياد تدريجياً.
تلك المناطق، يمكن أن تحصل على سبيل المثال على وضع دونيتسك ولوغانسك الحالي، أي تغدو كيانات معترفاً بها جزئياً مع قيام الاتحاد الروسي بإبرام اتفاقيات حول الصداقة والتعاون المتبادل معها. عملياً سيؤدي هذا إلى إنشاء منطقة عازلة، من شأنها أن تبعد الناتو عن روسيا، لكن هذا السيناريو لن يسمح بنزع السلاح في أوكرانيا بأكملها.
أما الحد الأعلى، أو المهمة القصوى، للعملية العسكرية فهو يشمل السيطرة على كل أوكرانيا. ومن المحتمل تماماً أن يتم تقسيم البلاد إلى نوفوروسيا (روسيا الجديدة)، التي تتكامل بشكل كبير مع الاتحاد الروسي، وبقية أوكرانيا، التي يحكمها، على سبيل المثال، فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة «من أجل الحياة».
مجلس الدوما الروسي يرى في ميدفيدشوك مفاوضاً مقبولاً في إطار وفد أوكراني يمكن أن يحاور روسيا بدلاً من الرئيس زيلينسكي، الذي لا تبدو عنده استقلالية كاملة في صنع القرار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عودة رجل الأعمال الثري رينات أحمدوف أخيراً إلى أوكرانيا لا تبدو مصادفة على الإطلاق. قد يحذو حذوه آخرون من رجال المال والأعمال الذين يرغبون في المحافظة على مصالحهم في أوكرانيا.
إذا تم التعامل على المستوى الأقصى للمهمة في أوكرانيا، فسوف تظهر لدى المناطق الغربية من أوكرانيا مشكلة خطيرة؛ خصوصاً أن لدى سكان هذه المناطق مشاعر سلبية للغاية تجاه موسكو. إذا تم منحهم الاستقلال، فإن موسكو عملياً سوف تعزز خطط وارسو، التي سيكون لها نفوذ قوي بالفعل على هذه المنطقة. هذا ينسحب جزئياً على مناطق أخرى، بينها مثلاً ترانسكارباثيان؛ حيث تعيش أقلية من أصول مجرية. عموماً سيؤدي هذا إلى تخفيف ضغط الغرب بشكل كبير، لكنه سيخلق حتماً بؤرة توتر جديد مع الاتحاد الروسي في المستقبل. لإضعاف تأثير هذا العامل، ينبغي أن يتم ضم بقية أوكرانيا في إطار اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي.
في الحالين، يتم تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا بحذر شديد. ليس فقط بهدف تقليص الخسائر بين السكان المدنيين، ولكن أيضاً بين القوات المسلحة لأوكرانيا، وبهدف الحفاظ على البنية التحتية المدنية. والأكيد أن موسكو لا تسعى إلى ضم أي أراضٍ أوكرانية. أمامها هدف واحد؛ نزع السلاح ونقل السلطة في أوكرانيا.
* خبير عسكري رئيس قسم في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة
————————-
أوكرانيا… لا يوجد بلد أهم!/ سيرغي فوروبيوف
تتركز أنظار المجتمع الدولي على الحرب في أوكرانيا التي تحولت إلى الحدث الأبرز في قلب السياسة الدولية اليوم. يعتبر التحول الدراماتيكي في العلاقات الروسية – الأوكرانية أمراً محورياً لتساؤلات وسائل الإعلام في العديد من البلدان. كيف تطور الوضع إلى هذه الدرجة، وما سبب غزو روسيا لدولة شقيقة؟ لا يسمح حجم مقالة للنظر بتفصيل كافٍ في تاريخ العلاقات بين الروس والأوكرانيين. وعموماً، ليس هذا هو الشيء الرئيسي الآن.
يُعتقد أن قرار الكرملين استند إلى عنصرين حاسمين. الأول، فشل الجانب الأوكراني في الامتثال لاتفاقيات مينسك، والقصف المستمر لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا ومعظم سكانهما من الروس، الذين تتعامل معهم كييف بصفتهم انفصاليين.
ما يتعلق باتفاقيات مينسك 2014 – 2015 التي وقعتها أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، من بين دول أخرى، ووافقت عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتم إقرارها في قرار خاص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان الغرض من هذه الوثائق هو حل النزاع المسلح في شرق الأراضي الأوكرانية من خلال تنفيذ «خريطة طريق»، تضمنت، من بين أمور أخرى، إجراء انتخابات حرة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. ومع ذلك، رغم المحاولات المستمرة للدبلوماسية الروسية لتشجيع الأوكرانيين على الامتثال لاتفاقيات مينسك، التي كان يجب أن تؤدي في النهاية إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة دونباس الصناعية القوية (إقليمي دونيتسك ولوغانسك) في إطار الدولة الأوكرانية، لم تقم كييف بأي خطوات لإحراز تقدم بشأن تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها. وواصلت رفض التعامل مع زعيمي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رغم أن توقيعاتهما كانت تذيل اتفاقيات مينسك.
في الوقت نفسه، رفضت كييف بشكل قاطع المساعدة في تنظيم الانتخابات في دونباس، مدركة أن نتائجها سوف تمنح شرعية للقوات الموالية لروسيا وفقاً للتوقعات. لقد انسحبت الدول الغربية من العملية، ولم ترغب في ممارسة ضغط فعال على الرئيس فولوديمير زيلينسكي. والأكثر من ذلك، فقد لمح الرئيس الأوكراني الحالي مراراً إلى أنه لا يخضع لاتفاقيات مينسك التي وقعها سلفه، «الفاسد» بيترو بوروشينكو. وهو أمر لا يعتد به عملياً من وجهة النظر القانونية.
العنصر الثاني، أنه خلال ثماني سنوات في دونباس، نتيجة قصف الجيش الأوكراني والاشتباكات المسلحة المفتوحة مع الميليشيات الشعبية المحلية، قُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف من السكان الموالين لروسيا. لم يقم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والطرفان الموقعان على الاتفاقيات، باريس وبرلين، بتقييم هذا الظرف بشكل صحيح.
بدا أنه توافرت لدى الرئيس فلاديمير بوتين الذريعة الكافية لاستخدام القوة، لحل المشكلة والخروج من دائرة «الحلقة المفرغة». في نفس الوقت، كان هناك بالطبع أكثر من سيناريو لاستخدام القوة. لكن في ظل غياب الشفافية في النخبة السياسية الروسية وعدم وجود فهم مشترك كامل للآفاق المحتملة، لم يكن هناك إجماع على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها روسيا في دونباس. والدليل على ذلك هو مشهد التوبيخ المهين، الذي وجهه الرئيس بوتين إلى رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، خلال الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي في 22 فبراير (شباط) .
أيضاً، برز مؤشر إلى ذلك خلال عمليات التصويت على قرار الاعتراف بالجمهوريتين في مجلس الدوما، إما عبر تصويت البعض ضد القرار، أو من خلال تغيب عدد من البرلمانيين في كتلة الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» خلال جلسة التصويت في مجلس الدوما في 15 فبراير. كان من الواضح أن القرار بالاعتراف سيتبعه عمل قوي. وفقاً لسيناريو – لأسباب مفهومة – لم يتم عرضه على النخب السياسية في البلاد.
في البداية، مع اندلاع الأعمال الحربية، ركزت الدعاية السياسية للحكومة الروسية على الحاجة إلى حماية الأشقاء في دونيتسك ولوغانسك من الاستفزازات المسلحة لـ«النازيين الأوكرانيين» في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
رغم أن التصريحات حول «النازية» كعامل مهيمن في الحياة الاجتماعية والسياسية الأوكرانية الحالية تبدو غريبة للغاية؛ إذ لا يمكن تجاهل أن كلاً من فولوديمير زيلينسكي وسلفه بيترو بوروشنكو من أبناء القومية اليهودية. بدلاً من ذلك، كان يجب التركيز على الأشكال المتطرفة للقومية الأوكرانية، التي اكتسبت في السنوات الأخيرة توجهاً واضحاً مناهضاً لروسيا، وهو أمر استخدمه الغرب بنجاح.
لذلك، مثل هذه الصياغة للقضية، ومن خلال توجيه العملية العسكرية ضد الأوكرانيين حصرياً على حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كان يمكن لقرار السيناريو العسكري للكرملين أن يلقى تفهماً أكبر إلى حد بعيد، على الأقل داخل المجتمع الروسي. ولكن، كما يقولون في روسيا «سارت الأمور على غير ما يرام».
وسرعان ما بدأت دوافع أخرى تسيطر على الدعاية المرتبطة بالعملية العسكرية، حول «تقويض النازية»، و«تجريد أوكرانيا من السلاح»، فضلاً عن إجبارها على التزام الحياد، أي الإعلان الواضح بالامتناع عن الانضمام إلى الناتو.
هنا يمكن ملاحظة أن الأغلبية المطلقة من الروس تعتبر عضوية جارتنا في حلف شمال الأطلسي غير مقبولة من وجهة نظر أمن الاتحاد الروسي. لكن سرعان ما اتضح أن قتال الجيش الروسي امتد إلى مناطق عديدة في الضفة اليسرى (الشرقية) لأوكرانيا، بما في ذلك العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى. والأخبار حول الأعمال القتالية المستمرة، واسعة النطاق، مليئة بالعديد من التزييفات. ومن الصعب للغاية تكوين رأي موضوعي حول حجم المعارك والخسائر في صفوف السكان المدنيين. هناك شيء واحد واضح، لقد اكتسب استخدام القوة طابعاً مفرطاً بشكل واضح، سواء من حيث الحجم أو النطاق الجغرافي.
أنا أعتبر هذا سوء تقدير خطيراً من جانب استراتيجيي الكرملين. علاوة على ذلك، بالنظر إلى الوضع الحالي اليوم، يستمر قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونباس، رغم تقارير القيادة العسكرية الروسية حول تحقيق انتصارات ميدانية. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي لما يسمى بالعملية الخاصة لحماية دونباس لم يتحقق بعد.
الأمر الآخر أنه تبين أن التنبؤات التي وضعت حول رد الفعل المحتمل على الحرب، أولاً وقبل كل شيء، داخل روسيا، ثم بالطبع في جميع أنحاء العالم، لم تكن صحيحة.
ليس من الواضح من الذي شارك في وضع هذه التنبؤات. أنطلق من قناعة بأنها إدارة الرئاسة. صحيح أنه، في ظل أي سيناريو، كان يمكن توقع رزم جديدة من العقوبات القادمة من الغرب، لكنها قد تختلف في حجم العواقب على الاقتصاد، والأهم هو الانعكاسات على صورة روسيا في العالم. تعرضت مواقف الرئيس بوتين في بلادنا، والتي بدت للكثيرين أنها لا تتزعزع، لضربة قوية. انهارت سوق الأوراق المالية الروسية (انخفاض أكثر من 40 في المائة)، وانهارت البورصة، وارتفع الدولار واليورو بشكل حاد (نحو 10 في المائة)، وغدا نحو 75 في المائة من السوق المالية للبلاد تحت العقوبات. خضعت الشخصيات الأولى في البلاد لقيود العقوبات. وهذه فقط نتائج القرار العسكري التي نراها حتى اليوم. قائمة النتائج السلبية يمكن أن تطول وتطول.
بالمناسبة، يمكن هنا لفت الأنظار إلى أن رهان الكرملين على تلقي دعم فعال من جانب الصين لم يتحقق.
أيضاً، في إطار النتائج المحتملة على الصعيد الجيوسياسي، ليس مفهوماً تماماً، لماذا لم يضع فريق مستشاري الكرملين في حساباته احتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة تبدو محتملة تماماً حالياً، خصوصاً أن القرار البرلماني في هذا الشأن تم اتخاذه بالفعل في هلسنكي. وربما يتبع ذلك انضمام السويد.
وضمن التداعيات اللاحقة، من الممكن توقع حظر تصدير العديد من التقنيات الحيوية والسلع الصناعية إلى روسيا، والتمييز في مجال الثقافة والرياضة وغير ذلك الكثير، وكل هذا لفترة غير محددة. بالإضافة إلى كل ذلك، برزت العديد من الاحتجاجات المناهضة للحرب في موسكو وسان بطرسبرغ ومدن روسية رئيسية أخرى.
أرى نتيجة إيجابية واحدة فقط: قد تقنع العقوبات الصارمة القيادة الروسية بتعديل سياساتها الاقتصادية بشكل جذري. والتوقف عن الاعتماد على تقريب الأوليغارشية المرتبطة، بشكل وثيق جداً، بالغرب، وتنفيذ إصلاحات جذرية تخدم المصلحة الوطنية – بالطبع، من دون التخلي عن التعاون الدولي.
اعتباراً من اليوم، الشيء الرئيسي هو وقف إراقة الدماء، والتخلي عن خطط – الحد الأقصى – فيما يتعلق بجارنا، وهذه الخطط معروفة فقط للكرملين.
في أيام انهيار الاتحاد السوفياتي كنت ضابطاً، أدرس في إحدى الأكاديميات العسكرية. نشر رفيقي في الجيش، ديمتري ترينين، الذي يشغل حالياً، منصب مدير مركز موسكو التابع لمؤسسة «كارنيغي»، في ذلك الوقت في المجلة الشعبية «نوفوي فريميا» مقالاً بعنوان «أوكرانيا: لا يوجد بلد أكثر أهمية». رغم حقيقة أنني لا أشاطر الآراء السياسية لديمتري وزملائه في الصندوق، أعتقد أن مثل هذا النهج تجاه القضايا الأوكرانية هو أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.
* أستاذ في «الجامعة الروسية الرسمية»، المدرسة العليا للاقتصاد. عقيد متقاعد. دبلوماسي سابق
الشرق الأوسط
————————–
جروح السيد الرئيس/ غسان شربل
لا تقل إن هذه الحرب بعيدة ولا تعنيك. إنها أعنف زلزال يضرب «القرية الكونية» منذ عقود وبعنف يوازي سبع درجات على مقياس ريختر. هذه حرب تعني سعر القمح والرغيف الذي يحتاجه أطفالك. وسعر الغاز الذي يساعدك في مكافحة الصقيع. وسعر الوقود الذي لا بد منه لسيارتك. إننا في عالم شديد الترابط، لهذا تبدو المغامرات الدامية فيه أشبه بأوجاع قطع الشرايين.
ولا مبالغة في القول إنها حرب بوتين. فهي من تأليفه وتلحينه. وتمس بالضرورة موقع بلاده في النظام الدولي الجديد الذي قد يولد هذه المرة من كييف لا من برلين. وتمس بالتأكيد موقعه داخل بلاده وبعدها موقعه بين أسلافه على صفحات التاريخ. ولأنها حرب بوتين يصعب عليه العودة عنها أو العودة منها من دون ثمن يبرر اندلاعها. مطالبة سيد الكرملين بالانسحاب من أوكرانيا بلا ثمن وضمانات تذكر مع الفوارق بمطالبة صدام حسين بالانسحاب من الكويت بلا ثمن وضمانات. وتقول الكتب إن صاحب القرار يسقط أحياناً أسير قرار تسرع في اتخاذه وإن عجزه عن قبول جرح في صورته أو هيبته يتسبب في «عواقب وخيمة».
الصحافة مهنة ماكرة ومثيرة تحبب إلى المنخرطين فيها جمع الحكايات وعقد المقارنات رغم الفوارق بين الأشخاص والمسارح والمراحل. شاهدت الفيديو المسرب عن اجتماع لمجلس الأمن القومي عقده بوتين لبحث موضوع الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين في أوكرانيا. لفتني ارتباك مدير المخابرات الروسية وحرص بوتين على استخراج الجواب الذي يريده منه. طالبه بجواب صريح وقاطع وكان له في النهاية ما أراد. ولأنني ابن الشرق الأوسط الرهيب تذكرت ما سمعت عن اجتماعات القيادة القطرية وقول صدام إنه قادر على اكتشاف الخونة من عيونهم وبمجرد التحديق بهم.
إنها تشوهات المهنة. راودني سؤال مفاده هل كان بوتين يحمل في السنوات القليلة الماضية مشروعاً لكسر رأس أوكرانيا السلافية التي سارعت إلى خيانة البيت السوفياتي وبخلت لاحقاً على روسيا برئيس موالٍ لها في كييف.
في سبتمبر (أيلول) 1979، ترأس صدام حسين وفد بلاده إلى قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت في بلاد فيديل كاسترو ولم يكن مضى على توليه الرئاسة سوى شهرين. على هامش القمة استقبل صدام في مقره بهافانا وزير الخارجية الإيراني إبراهيم يزدي في حضور عضو القيادة العراقية صلاح عمر العلي. بعد اللقاء الذي ترددت فيه النيات الطيبة قال صلاح لصدام إن اللقاء كان إيجابياً ويمكن البناء عليه لإزالة أسباب التوتر. استمع صدام باهتمام ثم قال: «يا صلاح انتبه. هذه الفرصة قد لا تتاح إلا مرة كل مائة سنة. الفرصة متاحة اليوم. سنكسر رؤوس الإيرانيين وسنعيد كل شبر احتلوه. وسنعيد شط العرب». وفي السنة التالية اندلعت حرب صدام ضد إيران وكان ما كان.
أنا لا أقول إن بوتين يشبه صدام. جاء الرجلان من نبعين مختلفين. ولا أقول إن وضع إيران بالنسبة إلى العراق يشبه وضع أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا. لكن الرئيس القوي يصاب أحياناً بهاجس ثأر يأخذه بعيداً ولأنه قوي يصطحب بلاده معه.
في بداية التسعينات وفي عهد يلتسين، سألت عن اسم الرجل القوي في البلاد، وهالني جواب يقول «إنه السفير الأميركي». وحين شاهدت بزات ضباط «الجيش الأحمر» تباع بحفنة من الدولارات في شارع أربات للمشاة في موسكو، سألت نفسي عن موعد الثأر الروسي. في بداية القرن أوكلت روسيا إلى رجل اسمه فلاديمير بوتين الثأر من إقدام الغرب على اغتيال الاتحاد السوفياتي بقوة النموذج والجاذبية ومن دون إطلاق الرصاص عليه.
كان صدام حسين يحمل في روحه جرحاً اسمه «اتفاق الجزائر» الذي وقّعه في 6 مارس (آذار) 1975 مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في حضور الرئيس هواري بومدين. تجرع صدام في الاتفاق سم التنازل عن شيء من سيادة العراق للتفرغ لإجهاض الثورة الكردية، وهو ما حصل. لكن السيد الرئيس لن يرتضي أن يسجل التاريخ أنه تنازل فأطلق الحرب ومزق الاتفاق وكان ما كان لاحقاً. وبعد الخروج منتصراً من الحرب سيحمل صدام جروح الديون مضافاً إليها جرح آخر.
في سبتمبر (أيلول) 1989، استقبل صدام أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الذي جاء مهنئاً بانتهاء الحرب مع إيران وقلده «وسام الرافدين» الرفيع. ثم فاجأ الرئيس العراقي ضيفه بورقة تتضمن نص مشروع معاهدة بين البلدين وكانت الطاولة القريبة جاهزة لمراسم التوقيع. لم يتوقع صدام أن يطلب الضيف ترك النص للمختصين في البلدين لدراسته. كظم صدام غيظه لكن الجرح استقر في روحه وفي السنة التالية أرسل جيشه لاجتياح الكويت.
لم يسلم صدام بحق الجار الكويتي في انتهاج سياسة مخالفة لتوجهات العراق. ولم يتقبل أن يطلب الرئيس العائد «منتصراً» من حربه مع إيران أن يواجه اقتراحه إبرام معاهدة مع الكويت بالرفض أو الإرجاء.
تتحول المشكلة إلى مأساة حين يحمل الرئيس القوي جروحاً كثيراً في روحه. تكاثرت الجروح في قلب الكولونيل السوفياتي الوافد من عتمة الـ«كي جي بي». جرح سقوط جدار برلين. وجرح دفع الاتحاد السوفياتي إلى المتاحف. وجرح فرار الجمهوريات من دون أن تذرف دمعة على البيت السوفياتي. وجرح تحريك حلف «الناتو» بيادقه في اتجاه حدود روسيا نفسها على وقع «ثورات ملونة» وتقاسم فظ للإرث السوفياتي. كانت خيانة أوكرانيا «أم الخيانات» لهذا راح يعد لـ«أم المعارك». مزق ثياب جورجيا وأوكرانيا. استعاد القرم وتدخل عسكرياً في سوريا. أغلب الظن أنه كان يستعد للمنازلة الكبرى على المسرح الأوكراني.
الذهاب إلى الحرب أسهل بكثير من الرجوع منها خصوصاً إذا كانت روسية وعلى المسرح الأوروبي. اصطدام الاجتياح الروسي بمقاومة أوكرانية مدعومة غربياً ينذر بعواقب عسكرية واقتصادية وسياسية وإنسانية. عواقب وخيمة. لقد أصيبت «القرية الكونية» بجرح شديد الالتهاب على مقياس ريختر.
الشرق الأوسط
—————————
إندبندنت: عنصرية ضد الأفارقة والعرب الفارّين من أوكرانيا.. والأولوية للبيض فقط
إبراهيم درويش
نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا من إعداد نادين وايت، قالت فيه إن عددا من الأفارقة المقيمين في أوكرانيا وجدوا أنفسهم عالقين وسط الغزو الروسي للبلد، انضموا إلى أفواج اللاجئين باتجاه الحدود مع بولندا، ولكن الجنود الأوكرانيين أمروهم بالنزول من الحافلات قائلين: “لا سود” يسمح لهم بالركوب، فقط البيض الأوكرانيون.
وقالت الصحيفة إن عددا من الأفارقة الذين يعيشون في المنطقة تحدثوا عن سوء المعاملة وتركهم عالقين لوحدهم، حيث لجأ الكثيرون منهم إلى “تويتر” للحديث عن تجربتهم.
وفي مقابلة مع الصحيفة، قال أوسارمين، والد ثلاثة أطفال، إنه وعائلته وعددا من المهاجرين، طُلب منهم النزول من الحافلة التي كانت ستسافر صوب الحدود يوم السبت وأُخبروا “لا سود”. ورغم تحديهم لسائق الحافلة والجنود، إلا أنهم أُجبروا على النزول منعا وتُركوا وحدهم. وقال: “منذ ذلك الوقت أحاول تجاوز الأمر والتركيز والتصرف بشكل طبيعي، لكن الأمر صعب”. وأضاف: “طوال حياتي كناشط، لم أر مثل هذا. وعندما أنظر في عيون الذين يمنعوننا من الدخول أرى دماً وعنصرية. يريدون إنقاذ أنفسهم ولكنهم يخسرون إنسانيتهم”. وقال: “لا أتخيل سيناريو يتم فيه منع لجوء أوكراني أبيض. الطريقة التي يعاملوننا فيها غير مبررة ولا أساس له، دعونا نتقاسم المأساة”. وأسارمين هو مواطن نيجيري يعيش في أوكرانيا منذ عام 2009 وتُرك حاليا عالقا في محطة قطار كييف مع آلاف آخرين، ولا يعرف ماذا سيحلّ به. وقال: “لا يحدث هذا للأفارقة فقط، ولكن للهنود والعرب والسوريين: يجب ألا يحدث هذا”.
وقال كريستيان (30 عاما) إنه تلقى مكالمة عبر الهاتف من صديقه وينستون في ميديكا، حيث زعم أنه شاهد الجيش الأوكراني يمنع مئات الأفارقة والجنسيات الأخرى من الذهاب إلى بولندا. وينتظر مقابلة وينستون، النيجيري في بولندا لكنه فقد الاتصال به، ربما لعدم توفر الشحن لهاتفه أو أمر أسوأ. وقال كريستيان إنهم أخبروا صديقي: “لا إنكليزية ولا بولندية ولا وسود”. وأضاف: “أتحدث إليك وأنا لم أنم منذ يومين وأخشى أن صديقي وأخي لم يعد موجودا، وأن شقيقي الأفريقي قد مات”. وقال: “الحقوق المتساوية يجب أن يحصل الجميع عليها، ولكن لا يحصل الأفارقة على حقوق متساوية مع الأوكرانيين البيض، وعلينا ألا نميّز، فكلنا بشر وهذه حرب”.
وانتشر تسجيل فيديو بشكل واسع على منصات التواصل، حيث مُنع بعض الناس من ركوب القطار، وظهر رجل صيني يصرخ على اللاجئين الأفارقة الذين يحصلون على المقاعد، مشيرا إليهم بـ”الناس السود”. وأُجبر 24 طالبا من جامايكا وصلوا بالقطار إلى مدينة لفيف على السير 24 كيلومترا نحو الحدود البولندية. وتأمل طالبة الطب كورين سكاي (26 عاما) التي تعيش في أوكرانيا منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بالمضي إلى الحدود بعد وصولها إلى لفيف. وقالت: “بعض السكان المحليين يعطون الأولوية للأوكرانيين ويكافح الأفارقة لركوب الحافلات، ويواجهون مواقف عدوانية أو مُنعوا من الدخول إلى الحدود”.
وتعمل سكاي على ترتيب سيارات الأجرة الجماعية لأن عددا من الطلاب فقراء، وليس لديهم المال الكافي للسفر ودفع مئات الجنيهات. ووصفت سكاي الأزمة التي تتكشف أمام ناظريها بأفلام القيامة، كما تحدثت عن الميليشيات المسلحة التي تتحرك في الطرقات وتلوح بالبنادق تحت نظر الجيش. وقالت إنها تعرضت للتهديد من المسلحين المحليين. وفي الأزمة الحالية، يُعتبر السود، وخاصة المهاجرون منهم، عرضةً للخطر، كما تقول. وأضافت سكاي: “كمجتمع نخشى من رجال الشرطة المسلحين. يتم إيقافنا باستمرار من مسلحين. أعتقد أنني أعيش على الأدرينالين في الوقت الحالي وأساعد الآخرين. نحن على الطريق ولهذا يجب أن أبقى هادئة حتى أقدم الدعم”.
وزعم من حاولوا عبور الحدود إلى بولندا أن حرس الحدود منعوا دخول اللاجئين الأفارقة. وفي نقاش على “تويتر سبيس”، شاركت فيه إندبندنت يوم السبت، عبّر مئات من المواطنين النيجيريين وعائلاتهم وأصدقاؤهم عن مأزقهم. وأثار الوضع غضبا بين المراقبين داخل الشتات الأفريقي والكاريبي الذي يشعرون أن قيمة الأفارقة لا تساوي البيض حتى في وقت الحرب.
وكتب الدكتور أيودي ألاكيجا، المبعوث الخاص إلى منظمة الصحة العالمية في تغريدة على تويتر: “يعامل الأفارقة بعنصرية واحتقار في أوكرانيا وبولندا. لا يمكن للغربيين الطلب من الدول الأفريقية التضامن معهم لو لم يظهروا الاحترام لنا في زمن الحرب. فقد تم تجاهلنا أثناء الوباء، وتركنا نموت في الحرب، أمر غير مقبول”.
وتعاني دول في شرق أوروبا من سيادة المشاعر اليمينية المتطرفة، لكن أوكرانيا بجامعاتها الرخيصة أصبحت مقصدا مفضلا للطلاب من أنحاء العالم. وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي للطائرات المدنية بما في ذلك كييف بسبب ما قالت إنها مخاطر. وهو ما أجبر الكثيرين على المشي لأيام نظرا لعدم توفر القطارات والسيارات. وقال إنزي، الطالب الأفريقي الذي مشى أياما نحو الحدود البولندية: “من الواضح أننا الأفارقة بشرٌ بدرجة متدنية”.
وقبل قراره المشي، حاول ركوب قطار من محطة كييف، ولاحظ هرمية تبدأ بالأطفال ثم النساء البيض والرجال البيض وأخيرا السود. وقال: “هذا يعني انتظارا لساعات في محطة القطار، ولم نستطع الركوب بسبب ذلك. وغالبية الأفارقة تنتظر للوصول إلى لفيف. كان علينا دفع النساء والأطفال الأفارقة لأنهم قالوا إن لهم الأولوية”.
ويدرس في أوكرانيا حوالي 4 آلاف طالبة وطالبة من نيجيريا، وهم ثاني أكبر نسبة من الطلاب الأجانب بعد المغاربة الذين يصل عددهم إلى 8 آلاف طالب. وقال السياسي النيجيري فيمي فان- كايودي: “بولندا والدول الأوروبية الأخرى المحيطة بأوكرانيا تسمح للأوكرانيين والهنود والعرب وبقية الجنسيات بعبور الحدود. الناس الذي يُمنعون هم الأفارقة السود. وفي الوقت الحالي هناك مئات من الطلاب الأفارقة علقوا على الحدود مع بولندا. الأسوا من هذا، هو أن الأوكرانيين يمنعون الأفارقة من ركوب القطارات التي وفروها مجانا لمغادرة أوكرانيا والهرب إلى أوروبا”.
وأضاف فان- كايدوي، الوزير السابق، إن “هناك تقارير عن دخول الشرطة الأوكرانية للقطارات وإنزال الأفارقة، قائلين إن عليهم الانتظار لحين دخول كل الجنسيات بمن فيهم الهنود. هذا هو مستوى الأفارقة في أسفل السلم”.
وقالت طالبة طب نيجيرية أخرى هي ميديكا شيهني، إنها انتظرت سبع ساعات للعبور إلى بولندا التي يوقف فيها حرس الحدود الأفارقة ويرسلونهم إلى آخر الطوابير، حتى يعبر الأوكرانيون أولا . وقالت سكاي إن “الوضع يكشف عن أحسن وأسوأ ما في البشر. أوقفنا الجنود والضباط المسلحون. كان بعضهم طيبا والآخر عدوانيا، تصبح أسوأ عندما تكون بشرتك داكنة”.
وقالت إن البعض قرر البقاء خوفا مما سيحصل له على الجانب الآخر. وحاول عدد من الطلاب النيجيريين استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة تجاربهم. وقالت سكاي: “نريد مساعدة السفارة، ولم نحصل على المساعدة لمغادرة أوكرانيا. كل ما حصلنا عليه من دعم هو من مجتمع الشتات. وتكذب بعض السفارات عبر التلفاز، وتزعم أنها تقدم الدعم لنا. نحن بحاجة لأكبر دعم ممكن، ولو حاولوا، فعليهم زيادة جهودهم، حتى السفارة البريطانية، أنا مواطنة بريطانية، ولكن السفارة ظلت صامتة”.
——————————-
بوتين وسياسة ما بعد حافة الهاوية/ طه عبد الواحد
في البحث عن إجابة على سؤال “ماذا يريد بوتين من العملية العسكرية في أوكرانيا؟”، يظهر طيف واسع من الاجابات، يتراوح ما بين أهداف استراتيجية، تتعلق بما أعلن عنه الجانب الروسي بخصوص (الضمانات الأمنية)، وأخرى تشمل إعادة تشغيل خطط السكك الحديدية البري الواصل بين روسيا والقرم، وضمان استمرار تزويد شبه الجزيرة بالمياه العذبة.
ولا يسقط وسط هذا كله هدف ربط مناطق السيطرة الروسية المحتلة في أوكرانيا مع منطقة بريدنيستروفيا في مولدافيا، التي تشهد نزاعا منذ السنوات الأخيرة من عهد جمهورية مولدافيا السوفياتية، وتعيش فيها غالبية ناطقة باللغة الروسية. وبغض النظر عن سير العملية العسكرية فمن الواضح أن بوتين سيسخر سيطرة قواته على أجزاء من أوكرانيا، كورقة ضغط لتحقيق جملة الأهداف هذه، حتى لو كان عبر المفاوضات مع الأوكرانيين.
في الحديث عن الهدف “الاستراتيجي”، الذي يسعى بوتين إلى تحقيقه من إرسال قواته إلى أوكرانيا، تكفي العودة إلى خطابه يوم 24 شباط/فبراير، الذي أعلن فيه عن تلك العملية، وشكك خلالها بوجود أوكرانيا ككيان ودولة مستقلة، واعتبرها كياناً كان ضمن الامبراطورية الروسية، ظهر على شكل دولة نتيجة سلسلة أخطاء ارتكبها القادة السوفيات، من لينين وحتى خروشوف. في ذلك الخطاب قال بوتين إن الهدف من العملية “ضمان أمن وسلامة المواطنين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك”. وكان قد مهد لهذه الخطوة وفق مخطط دقيق كما يتضح. إذ أعلن أولاً اعترافه باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين في أوكرانيا، ومن ثم مباشرة وقع معهما اتفاقيات تشمل الدفاع المشترك. وقال إنه بناء على طلب من رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين قرر إرسال تلك القوات.
اللافت في الأمر أنه في الوقت الذي أعلن فيه بوتين عن قراره، كانت جميع الأخبار الواردة من خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والميشلشيات الموالية لروسيا في لوغانسك ودونيتسك، تشير إلى بقاء الوضع على حاله في المنطقة، حيث يجري في بعض الأحيان خرق لوقف إطلاق النار، وتبادل للقصف أو إطلاق النار. أي أنه لم تطرأ مستجدات ميدانية تستدعي مثل هذا التدخل العسكري وبهذه الطريقة وبهذه السرعة.
يبدو أن السبب الرئيسي الذي دفع بوتين لاتخاذ ذلك القرار، يعود إلى تبلور قناعة لديه بأن الغرب لن يتراجع في إصراره على رفض إجراء محادثات مع روسيا حول اقتراحاتها بشأن الضمانات الأمنية، والتي تشمل مطالب روسية رئيسية، منها: الالتزام بعدم توسع حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وبصورة خاصة عدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى صفوفه؛ وعدم نشر الحلف ودول الغرب أسلحة هجومية في المناطق القريبة من روسيا، وعودة انتشار القوات العسكرية في أوروبا الشرقية إلى ما كانت عليه قبل عام 1997، أي قبل موجة توسع الناتو وضم معظم دول أوروبا الشرقية إلى صفوفه، ونشر قواته فيها.
ويتضح من طبيعة الهجمات التي تشنها القوات الروسية على أهداف في مختلف المدن الأوكرانية، وتوغلها في عمق الأراضي الأوكرانية، بعيداً عن إقليم دونباس، شرق أوكرانيا، حيث تقع لوغانسك ودونيتسك، أن “حماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك”، ليست أكثر من مبرر يستغله بوتين كغطاء لعملية عسكرية لتحقيق جملة أهداف:
أولاً: الإجبار على التفاوض والقبول بالمقترحات الروسية.
كان لافتاً أن تزامن إعلان روسيا عن تسليمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الاقتراحات لتقديم ضمانات أمنية، مع تحركات ضخمة للقوات الروسية، وانتشارها في بيلاروسيا وغرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، ضمن مناورات واسعة شملت مناطق أقصى شمال روسيا، وشاركت فيها القوات الروسية في سوريا والمتوسط. ولعل الروس اعتقدوا أن تحركات بهذا الشكل لقواتهم، قد تكون عامل ضغط مؤثر على الغرب في المفاوضات حول الضمانات الأمنية. إلا أنه وبعد الرفض الغربي الحازم لمنح روسيا ما تريده، يبدو أن بوتين قرر دفع الأمور إلى “ما بعد حافة الهاوية”، والقيام بعملية عسكرية يعلن عبرها استعداده لحرب حتى لو تحولت إلى “حرب عالمية ثالثة” تدمر الجميع، على أمل ترهيب دول الغرب لكسر تصلبهم، وإجبارهم على بحث المطالب الروسية، ووفق شروط قد تمليها موسكو، بعد أن أظهرت استعدادها لأسوأ السيناريوهات، أي المواجهة العسكرية الكبرى، في حال استمر تجاهلها.
ثانياً: جعل أوكرانيا منطقة لضمان أمن روسيا، قبل أن تصبح رأس حربة للناتو في العمق الروسي.
من غير المستبعد أن بوتين، وبعد أن فقد الأمل في تحصيل ما يريده من الغرب عبر التفاوض، قرر أن يقوم بخطوة استباقية، وأن يحتل أوكرانيا، ويقوم بتنصيب نظام حكم فيها يكون تابعاً وموالياً للكرملين، ويعلن سياسة التقارب مع روسيا، وفق صيغة أكثر إغراءً حتى من صيغة التقارب بين روسيا وبيلاروسيا. وبالتالي تصبح أوكرانيا، مثل بيلاروسيا حالياً، قاعدة متقدمة في عمق مناطق سيطرة حلف ال”ناتو”، تستخدمها القوات الروسية وفق ما تراه مناسباً دون قيود. وفي حال تحقق هذا السيناريو، تصبح مسألة بناء “دولة اتحاد سلافية” وتشكيل حلف ثلاثي روسي-بيلاروسي-أوكراني شبيه بدولة الاتحاد الروسية-البيلاروسية تحصيل حاصل. وهذا وفق الرؤية الروسية سيبعد تهديد حلف الأطلسي نوعاً ما عن العمق الروسي، ويقوي موقف روسيا التفاوضي حول إعادة بناء منظومة الأمن والاستقرار الاستراتيجي.
ثالثاً: ربط شبه جزية القرم برياً “مع الوطن الأم روسيا” وضمان إمداداتها بالماء العذب من الدنيبر في أوكرانيا، والوصل مع بريدنيستروفيا.
في عام 2015، ورداً على سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم وضمها إلى “قوام الاتحاد الروسي”، أغلقت أوكرانيا القناة التي كانت توفر أكثر من 80 في المئة من المياه العذبة لشبه الجزيرة، كما أوقفت حركة القطارات من روسيا إلى القرم عبر الأراضي الأوكرانية، دون وجود بديل بري للربط مع روسيا. لحل المشكلة الأولى أطلقت روسيا مشروعاً لتجميع مياه الأمطار خلف سدود وتنقيتها وتزويد السكان بها. ولحل مشكلة الربط البري نفذت روسيا مشروع بناء جسر عبر مضيق كيرتش، لعبور السيارات ومن ثم القطارات، إلا أنه لم يحقق الحلم بربط بري طبيعي بين الجانبين. الآن، ومع دخول القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية، كان واضحا أنها ركزت على التوجه نحو الشرق، ومن ثم جنوب الشرق، باتجاه مناطق البر الأوكراني المتصلة مع البر في شبه جزيرة القرم، وهي المناطق التي توجد فيها قناة تزويد شبه الجزيرة بالماء.
وحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية، قامت القوات بتدمير السد الذي شيدته أوكرانيا على تلك القناة، وبدأ تزويد القرم عبرها بالماء. أما مسألة الربط برياً بين روسيا والقرم، فهي تحصيل حاصل، بعد أن سيطرت القوات الروسية -حسب تصريحات الجانب الروسي على الأقل- على الأجزاء الرئيسية من مناطق جنوب شرق أوكرانيا، الممتدة على ساحل البحر الأسود، حتى حدود مدينة أوديسا. ولا يمكن استبعاد سيناريو التقدم واحتلال أوديسا وما بعدها للوصول إلى الحدود الأوكرانية مع منطقة بريدنيستروفيا من جمهورية مولدافيا.
أخيراً، فإن التركيز على مدينة خاركوف يدل أيضاً على الرغبة بإعادة تشغيل خط السكك الحديدية الواصل بين موسكو وشبه جزيرة القرم، مروراً بالبر الأوكراني، وذلك عبر مدينة خاركوف، ومدن أخرى، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بعضها، ومحاصرة أخرى، وفق بيانات وزارة الدفاع الروسية. وبالتالي يمكن القول بشكل عام إن روسيا، ضمن هذا السيناريو ستعمل وفق أقل تقدير للسيطرة على المساحات الممتدة من خاركوف شمال شرق أوكرانيا، والتوجه جنوباً نحو بولتافا، وصولاً إلى كريفوي روغ في وسط الجزء الشرقي، ومنها نحو نيكولايف في الجنوب الشرقي على الحدود الإدارية لأوديسا، على ساحل البحر الأسود. فضلاً عن ما سبق كله فإن بحر آزووف سيصبح بحرا داخليا في حال تحقق هذا السيناريو.
مع انطلاق المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، فإن الكرملين سيعمل على تحقيق الجزء الأكبر من هذه الأهداف، لكن عبر الحوار، وسيحاول استغلال تقدمه عسكرياً كورقة لفرض رؤيته وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه.
——————————-
عزمي بشارة:روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو..تأملات بعدم تجنّب الحرب
نشر المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة دراسة جديدة بعنوان “روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو” جاء فيها:
انتابت روسيا الاتحادية مع تولي فلاديمير بوتين رئاستها بالوكالة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999، ثم بالأصالة بعد الانتخابات الرئاسية في 26 آذار/مارس 2000، “صحوة” للعمل على التحول من دولة مهدَّدة بأن تصبح دولة من الدرجة الثانية وربما الدرجة الثالثة في العالم، بحسب تعبير بوتين، لتعود قوة عظمى، عبّر عنها في رسالته التي وجهها في أواخر عام 1999، وحملت عنوان “روسيا على العتبة الألفية الجديدة”، وأصبحت تُعرف لدى المتخصصين بالشؤون الروسية ب”رسالة الألفية”.
أفصح بوتين عن رؤيته تلك إلى العالم بوضوحٍ بالغ، فما ورد في رسالة الألفية لم يكن موجهاً إلى الاستهلاك الروسي الداخلي في روسيا منهكة ومتداعية في مرحلة التسعينيات، بل إلى العالم.
جاء التدخل في جورجيا في عام 2008 خطوة عملية أولى لترجمة “الفكرة الروسية” في سياق رؤية رسالة الألفية للتحول إلى دولة عظمى، وذلك بحجة الدفاع عن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهما منطقتان سعتا إلى الانفصال وتأسيس جمهوريتين مستقلتين بدعم روسيا وحمايتها، ثم جاء التدخل في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وفي الحالتين حذرت موسكو منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وحتى الاتحاد الأوروبي في بروكسل من مواصلة توسيع نفوذهما في جمهوريات تعتبرها ضمن مجالها الحيوي؛ أي مجال الفكرة الروسية “The Russian Idea”، وتحديداً في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا. وتبع ذلك تدخل روسي عسكري سافر في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015، أصبح بعده وجوداً عسكرياً شبه دائم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وربط بين القاعدة الجديدة في طرطوس وبين سيباستوبل، مقر قيادة الأسطول الروسي، لتعود روسيا إلى الشرق الأوسط من البوابة السورية.
بعد أن مرت كل هذه العمليات دون رد غربي حاسم، وفي ظل وجود إدارة أميركية ذات موقف شديد السلبية من سياسات بوتين، وإزاء احتمال استفحال هذا الموقف، رأى الأخير أن يستبق التطورات بطلب تعهدات وضمانات أمنية واضحة من الولايات المتحدة، دبلوماسياً في البداية، ثم على شكل إنذار تمثل بحشد الجيوش على الحدود الأوكرانية، وتلا ذلك اعتراف روسي بالجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، وذلك في 21 شباط/ فبراير 2022، ثم الحرب الفعلية التي بدأت بتغطية جوية وصاروخية لتحرك الانفصاليين على الأرض لاحتلال كامل إقليم الدونباس شرق أوكرانيا ثم اقتحام الجيش الروسي مناطق أخرى في أوكرانيا، ولا يُعرف حتى الآن كيف ستنتهي هذه الحملة العسكرية.
أقرت روسيا في عام 2021 استراتيجية جديدة للأمن القومي الروسي حلت محل الاستراتيجيات السابقة، وعبرت هذه الاستراتيجية عن “تحول في الأولويات الإستراتيجية لروسيا”. ففي إستراتيجية 2015، خصصت فقرة مطولة لإشكالية علاقتها مع الناتو ورفضها نشاطه العسكري الزائد، وتمدده باتجاه حدودها، لكنها أبرزت اهتمامها بالحوار مع الاتحاد الأوروبي، و”تنسيق عمليات التكامل” في الجمهوريات السوفياتية السابقة. أما في استراتيجية 2021، فقد أكدت ما ورد في استراتيجية 2015 من تحفظات شديدة على الناتو، لكنها لم تعد مهتمة بالحوار مع بروكسل.
في ضوء هذا التحول في الأولويات الاستراتيجية، تقدمت روسيا بمطالب ذات طبيعة جيو-استراتيجية أمنية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وذلك في مسودة معاهدة سُلِّمت لدبلوماسي أميركي في موسكو. وتضمنت طلب الحكومة الروسية تعهدات بوقف توسّع حلف الناتو شرقاً وتجميد توسيع البنى التحتية له، مثل منظومات السلاح والقواعد العسكرية، في أراضٍ سوفياتية سابقة، ووقف تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، ووقف نصب الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا.
كانت مسودةُ المعاهدة، إذا ما شُرحت في ضوء نسق بوتين العقيدي، نوعًا من “إنذار مبطّن” للولايات المتحدة في أنّ هناك يوماً تالياً إن لم تستجب للتفاوض حولها والتوصل إلى تسوية مقبولة بشأنها تخفف من المخاوف الأمنية الاستراتيجية الروسية.
رفضت الولايات المتحدة هذه المطالب. ووصفها الرئيس الأميركي جو بايدن في رده في 22 شباط/ فبراير على خطاب بوتين قبل ذلك بيوم، والذي اعترف فيه باستقلال الانفصاليين بأنها “مطالب متطرفة”، ما قد يختلف كثيرون بشأنه؛ لأن هذه المطالب، أولًا، كانت قابلة للتفاوض، وثانياً، لأنه يمكن تصور تقديم مثلها من طرف أي دولة تعد نفسها دولة عظمى بشأن نشاط أحلاف عسكرية ليست عضوًا فيها على حدودها، وثالثًا، لأن هذه المطالب أقل تطرفاً من خيار الحرب. كما أن هناك فرصة للتفاوض لتفعيل اتفاقات مينسك المغطاة شرعيًا من الأمم المتحدة.
*****
كانت الحرب في أوكرانيا متوقعة، وكادت الولايات المتحدة تحددها بالساعة. ومع أن روسيا أنكرت مراراً نيتها احتلال أوكرانيا وضمّها، لكنها لم تنكر استعدادها لاستخدام الوسائل المناسبة كافة امنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو. لقد نشأ في روسيا نظام سلطوي ذو أيديولوجية معادية لليبرالية، ويمكن تسميتها بقومية الدولة العظمى. وتسعى روسيا إلى إعادة صياغة نظام الأمن الأوروبي بحيث تؤخذ مناطق نفوذها ودورها بوصفها دولة عظمى في الاعتبار. ويقود روسيا منذ عام 2000 رئيس يحكم البلد فعلياً ويؤمن بدور متعاظم للدولة، وبسياسات القوة خارجيا ولا يلتزم بمبدأ ما في العلاقات الدولية سوى مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول العظمى.
وعلى الرغم من توقع الحرب، لم تُبذل جهود كافية لوقفها، وذلك ليس بالزيارات والإنذار من العواقب، والتلويح بالعقوبات، بل بالبحث عن تسويات. نتيجة لأسباب سياسية داخلية، وأخرى متعلقة بالسلوك الروسي في العقد الأخير، لم تكن الدول المعنية، ولا سيما الولايات المتحدة، جاهزة لإيجاد تسوية، ولذلك دفعت أوكرانيا الثمن وهي الدولة التي لم يُتح لها فرصة التفاوض، ولا أُخذت مصالحها في الاعتبار.
حتى لو لم يزعج روسيا نشوء الديمقراطية في الدول المحيطة لها، فإن العملية الديمقراطية قادت دائماً إلى طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو الذي عدته الولايات المتحدة والدول الغربية أمراً طبيعياً في حين عدّته روسيا تهديداً لها. ولم تحاول الولايات المتحدة الفصل بين الديمقراطية والانضمام إلى حلف الناتو من أجل فتح هامش لتفهم الهموم الأمنية لدولة غير ديمقراطية، ولكنها دولة عظمى، أو تشدد كثيراً في سلوكها السياسي على أنها دولة عظمة ولم يعد النظام في روسيا معاديًا لليبرالية فقط، بل أصبح معادياً للدميقراطية ومؤيداً للسلطوية والانقلابات العسكرية على المستوى العاملي أيضاً، إذ أصبح يرى في الديمقراطية امتداداً لنفوذ الولايات المتحدة وحلف الناتو.
من منظور ما يمكن تسميته “الواقعية الأمينة”، قد تُعتبر الخطوات التي تتخذها دولة بوصفها مهمة لأمنها تهديداً لدولة أخرى لا تجمعها بالدولة الأولى علاقات ثقة. فتقوم هي أيضاً باتخاذ خطوات تعتبرها مهمة لحماية نفسها، وترى الدولة الأولى هذه الخطوات تهديداً لها. وهكذا، تنشأ عملية تصعيد أمني لا يمكن إنهاؤها في غياب ثقة ببين الأطراف إلا بالاستعداد للتفاوض والتوصل إلى تفاهم أولاً بشأن تجنب الحرب، ثم بشأن الطرق التي يمكن بواسطتها تطوير مفهوم مشترك للأمن.
في أوكرانيا توجد علاقة وثيقة بين مسألة الانضمام إلى الأحلاف وبين الديمقراطية؛ لأن القضية مرتبطة بشروخ اجتماعية داخلية كبرى. حسم هذا الموضوع انتخابياً يزعزع استقرار الديمقراطية. وتحييد أوكرانيا هو الحل لمسألة روسيا وحلف الناتو، كما أنه الجواب على أحد أهم مصادر عدم استقرار الديمقراطية في أوكرانيا. لم يتطرق المقال إلى المستقبل، الذي يصعب توقعه نتيجة لتضافر عوامل كثيرة متشابكة، ولكن لا شك في أنه إذا كانت العقوبات الغربية حازمة ومثابرة، وإذا تواصلت المقاومة في أوكرانيا، فسوف يكون لهما أثر في إضعاف نظام بوتين داخل روسيا نفسها، وأيضا في نوع التسوية التي يمكن التوصل إليها مستقبلاً.
—————————-

بوتين خسر الحرب..حتى لو فاز بالمعارك الميدانية
رأى المؤرخ والباحث البريطاني يوفال نوح هراري في مقال بصحيفة “الغارديان” البريطانية بعنوان: “لماذا خسر بوتين الحرب”، أنه بعد أقل من أسبوع على الحرب التي شنتها روسيا على السيادة الأوكرانية، يبدو من المرجح بشكل متسارع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجه نحو هزيمة تاريخية. وقد يفوز بكل المعارك الميدانية لكنه قد يخسر الحرب الكبرى التي يخوضها.
كان حلم بوتين بإعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية قائماً دائماً على خرافة أن أوكرانيا ليست أمة حقيقية، وأن الأوكرانيين ليسوا شعباً مستقلاً بحد ذاته، وأن سكان كييف وخاركوف يتوقون إلى عودة حكم الروس. وهذه وفقاً للباحث البريطاني، كذبة كاملة، لأن أوكرانيا دولة لها أكثر من ألف عام من التاريخ، وكانت كييف بالفعل عاصمة كبرى عندما لم تكن موسكو حتى قرية. لكن بوتين ينطبق عليه المثل “كذب الكذبة وصدقها”.
القوة لا تصنع انتصاراً
ويرى هراري أنه عند التخطيط لغزو أوكرانيا، كان بإمكان بوتين الاعتماد على العديد من الحقائق المعروفة. كان يعلم أن روسيا تقزّم أوكرانيا عسكريا. كان يعلم أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” لن يرسل قوات لمساعدة أوكرانيا. كان يعلم أن الاعتماد الأوروبي على النفط والغاز الروسي سيجعل دولاً مثل ألمانيا تتردد في فرض عقوبات صارمة. بناءً على هذه الحقائق المعروفة، كانت خطته هي ضرب أوكرانيا بقوة وسرعة، وقطع رأس حكومتها، وإنشاء نظام يحركه العسكر في كييف، ومن ثم الذهاب لمفاوضات تخلصه من نار العقوبات التي تصلي اقتصاده المنهار أصلاً كإمتداد لدول الشرق التي لا تعنيها التنمية والاقتصاد.
لكن كان هناك شيء واحد مجهول كبير حول هذه الحرب، كما يقول هراري حيث تعلم الأميركيون في العراق وتعلم السوفييت في أفغانستان، فإن غزو بلد ما أسهل بكثير من السيطرة عليه. بوتين يدرك أن لديه القوة لغزو أوكرانيا. لكن هل سيقبل الشعب الأوكراني فقط نظام موسكو الدمية؟ راهن بوتين على أنهم سيفعلون ذلك.
مع مرور كل يوم، أصبح من الواضح أن مقامرة بوتين تفشل. يقاوم الشعب الأوكراني من صميم قلبه، ويحظى بإعجاب العالم بأسره – وينتصر في الحرب. العديد من الأيام المظلمة تنتظرنا. قد يستمر الروس في احتلال أوكرانيا بأكملها. لكن للفوز بالحرب، سيتعين على الروس أن يسيطروا على أوكرانيا، ولن يتمكنوا من فعل ذلك إلا إذا سمح الشعب الأوكراني لهم بذلك. ويبدو على نحو متزايد، أن هذا الأمر غير مرجح الحدوث.
بوتين وصناعة العداء
يكمل المؤرخ البريطاني قائلاً: “تدمير كل دبابة روسية وقتل كل جندي روسي يزيدان من شجاعة الأوكرانيين للمقاومة. وكل قتيل أوكراني يعمق كراهية الأوكرانيين تجاه المحتلين”. ويرى أن الكراهية هي أبشع المشاعر. لكن بالنسبة للدول المضطهدة ، فإن الكراهية هي كنز مخفي، مدفون في أعماق القلب، يمكنه الحفاظ على المقاومة لأجيال.
لإعادة تأسيس الإمبراطورية الروسية ، يحتاج بوتين إلى نصر غير دموي نسبياً سيؤدي إلى سلام غير مفروض بالدماء والتدمير، بينما ما يقوم به الرئيس الروسي يؤكد أن حلمه لن يتحقق أبداً. لن يكون اسم ميخائيل غورباتشوف مكتوباً على شهادة وفاة الإمبراطورية الروسية: سيكون اسم بوتين. وغورباتشوف ترك الروس والأوكرانيين يشعرون بأنهم أشقاء. لقد حولهم بوتين إلى أعداء، وتأكد من أن الأمة الأوكرانية ستعرف نفسها من الآن فصاعداً على أنها مناوئة لروسيا.
فيما الرئيس فلاديمير زيلينسكي رفض الفرار من العاصمة، وقال للولايات المتحدة إنه يحتاج إلى الذخيرة وليس الهروب واللجوء. والجنود من جزيرة الأفعى الذين قالوا لسفينة حربية روسية: “اذهبوا لتضاجعوا أنفسكم”؛ والمدنيون الذين حاولوا إيقاف الدبابات الروسية بالجلوس في طريقها. هذه هي الأشياء التي تُبنى منها الدول. على المدى الطويل، تعد هذه القصص أكثر أهمية من الدبابات.
لذا يجب أن يعرف “الطاغية الروسي” هذا مثل أي شخص آخر. عندما كان طفلاً، نشأ على نظام غذائي من القصص عن الشجاعة الروسية في حصار لينينغراد. إنه الآن يخلق المزيد من هذه القصص، لكنه يلقي بنفسه في دور الزعيم النازي أودلف هتلر.
أوكرانيا التي أصبحت أمة
يختم يوفال نوح هراري قائلاً: “قصص الشجاعة الأوكرانية تعطي العزم ليس فقط للأوكرانيين، ولكن للعالم أجمع. إنهم يعطون الشجاعة لحكومات الدول الأوروبية، وللإدارة الأميركية، وحتى لمواطني روسيا المضطهدين. إذا تجرأ الأوكرانيون على إيقاف دبابة بأيديهم العارية”، ويمكن للحكومة الألمانية أن تجرؤ على تزويدهم ببعض الصواريخ المضادة للدبابات، ويمكن للحكومة الأميركية أن تجرؤ على عزل روسيا عن “سويفت”، ويمكن للمواطنين الروس أن يجرؤوا على إظهار معارضتهم لهذا الأمر الذي لا معنى له، “الحرب”.
لكن لسوء الحظ ، من المرجح أن تكون هذه الحرب طويلة الأمد. لكن القضية الأكثر أهمية قد حُسمت بالفعل. لقد أثبتت الأيام القليلة الماضية للعالم بأسره أن أوكرانيا هي أمة حقيقية، وأن الأوكرانيين شعب حقيقي، وأنهم بالتأكيد لا يريدون العيش في ظل إمبراطورية روسية جديدة. السؤال الرئيسي الذي تُرك مفتوحاً هو كم من الوقت ستستغرق هذه الرسالة لاختراق جدران الكرملين السميكة.
—————————–
كتّاب العالم يتضامنون مع أوكرانيا…حرب بوتين اعتداء على الديموقراطية
أصدرت مجموعة من الكتّاب حول العالم بياناً ضد الحرب، معلنةً تضامنها مع أوكرانيا. وجاء في البيان:
إلى أصدقائنا وزملائنا في أوكرانيا،
نحن، كتاب حول العالم، مروّعون من أعمال العنف التي شنتها القوات الروسية على أوكرانيا، وندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء.
نحن نقف متحدين في إدانة حرب خرقاء، شُنّت بسبب رفض الرئيس بوتين قبول حق الشعب الأوكراني في مناقشة ولائهم المستقبلي وتاريخهم دون تدخل من موسكو.
نقف متحدين في دعم الكتّاب والصحافيين والفنانين وكل الشعب الأوكراني، الذين يعيشون أحلك أيامهم. نقف بجانبكم ونشعر بآلامكم.
لكل فرد الحق في السلام وحرية التعبير وحرية التجمع. حرب بوتين هي اعتداء على الديموقراطية والحرية، ليس فقط في أوكرانيا، لكن في جميع أنحاء العالم.
إننا نقف متحدين في الدعوة إلى السلام وإلى وضع حد للدعاية التي تروج للعنف.
لا يمكن أن تكون أوروبا حرة وآمنة، من دون أن تكون أوكرانيا حرة ومستقلة.
الموقّعون/ Signatories
Burhan Sonmez, Svetlana Alexievitch, Margaret Atwood, Paul Auster, Tsitsi Dangarembga, Anthony Doerr, Jonathan Franzen, Aleksandar Hemon, Siri Hustvedt, Yann Martel, Joyce Carol Oates, Orhan Pamuk, Maria Ressa, Elif Shafak, Colm Toibin, Olga Tokarczuk, Ludmila Ulitskaya.
Jane Aaron, Evelyne Abitbol, Gabriela Adameșteanu, Kathrin Aehnlich, Inger-Mari Aikio, Ayad Akhtar, Bjanka Alajbegović, Päivi Alasalmi, Frank Albrecht, Amir Alić, Carlos Alonso Aníbal, Najat Alsamad Abed, Vicenç Altaió, Armas Alvari, Hazem Al Amin, Frances An, Ida Andersen, Henrika Andersson, Ben Andoni, Stanko Andrić, Dan Anghelescu, Éilís Ní Anluain, Liviu Antonesei, Lisa Appignanesi, Marie Arana, George Ardeleanu, Chloe Aridjis, Homero Aridjis, Gabriele von Arnim, Alexander Arkhangelsky, Ingeborg Arlt, Jordi Bergonyó i Aroca, Damir Arsenijević, Mona Arshi, Lea Cohen-Augsburger, Anisa Avdagić, Mihail Ayzenberg, Marianne Backlén, Elena Baevskaya, Vasile Baghiu, Tomica Bajsić, Leonid Bakhnov, Catherine Banner, Snježana Banović, Jürgen Banscherus, Ekaterina Barabash, Renato Baretić, Sheila Barrett, Nune Barsegian, Cikuru Batumiké, Juergen Baumann, Nurcan Baysal, Youseff Bazzi, Adisa Bašić, Almir Bašović, Germaine Beaulieu, Dirk-Uwe Becker, Simon Beckett, Sharmilla Beezmohun, Seida Beganović, Nadezhda Belenkaya, Amanda Bell, Gaston Bellemare, Timba Bema, Abdelkader Benali, Grațiela Benga, Vicent Berenguer, François Berger, Tewin van den Bergh, Mal Berisha, Michèle Bernard, Vicenç Llorca Berrocal, Rosaleen Bertolino, Abbass Beydoun, Emilie Bilman, Ana Blandiana, Sylvia Bledow, Gerda Blees, Anna Blume, Isabel Bogdan, Iulian Boldea, Fióna Bolger, Jennifer Finney Boylan, Barbara Bongartz, Javier Bonilla, Virginie Borel, Virginie Borel, Carmen Borja, Marina Boroditskaya, Alla Bossart, August Bover, Corin Braga, Colm Breathnach, Marta Breen, Per Bregengaard, Alida Bremer, Alida Bremer, Hans Maarten vd Brink, Roberto Briones, Ricky Monahan Brown, Keira Brown, Marta Nadal Brunès, Mikael Brygger, Siv Bublitz, Simone Buchholz, Romulus Bucur, Olga Bukhina, Diana Burazer, Ahmed Burić, Dragan Bursać, Paddy Bushe, Anton Carrera i Busquets, Pat Butler, Ida Börjel, Jan Bürger, Oriol Pi de Cabanyes, Morana Čale, Jenni Calder, Lynn Caldwell, Drew Campbell, Siobhan Campbell, Daniel Canty, Eibhlis Carcione, Kristina Carlson, Antònia Carré-Pons, Àngels Castells Cabré, Dragica Čarna, Jaume Creus i del Castillo, Sara Martínez Castro, Arben Çejku, Branko Čegec, Ruxandra Cesereanu, Jade Chang, Natalia Chepik, Ron Chernow, Tatyana Chernysheva, Herménégilde Chiasson, Ioana Cistelecan, Antoni Clapés, Jennifer Clement, Nicolae Coande, Jonathan Coe, Anthony Cohan, Pep Coll, Marian Coman, Denisa Comănescu, Colm Mac Confhaola, Micheál Ó Conghaile, June Considine, Philippe Constantin, Angélica Altúzar Constantino, Liliana Corobca, Željka Čorak, Costigan, Florica Courriol, Robert Craven, Jaume Creus, Bogdan Crețu, Pádraig Ó Cuinneagáin, Tony Curtis, Darko Cvijetić, Grozdana Cvitan, Gearóidín Nic Cárthaigh, Magda Cârneci, Svetlana Cârstean, Bianca Côté, Mircea Cărtărescu, Nerzuk Ćurak, Denis Dabbadie, Gabriel Daliș, Joan eusa Dalmau, Hasan Daoud, Job Degenaar, Astrid Dehe, Marija Dejanović, Dinko Delić, Peter Demeny, Enkel Demi, Ajla Demiragić, Denise Desautels, Jean-Marc Desgent, Martina Devlin, Sadhbh Devlin, Tadhg Mac Dhonnagáin, Margot Dijkgraaf, Vitaly Dikson, Simona-Grazia Dima, Adina Dinițoiu, Adriaan van Dis, Greg Dinner, Peggy Dobreer, Caius Dobrescu, Veronica Dolina, Salvador Domènechi Domènech, Jackie Mac Donncha, Gerry Mc Donnell, Katie Donovan, Ariel Dorfman, Theo Dorgan, Kevin Doyle, Elma Drayer, Proinsias Ó Drisceoil, Olga Drobot, Daniela Dröscher, Lison Dubreuil, Anne Duden, Dave Duggan, Catherine Dunne, Louise Dupré, Samantha Dunn, Can Dündar, Ferida Duraković, Denisa Duran, Don Duyns, Benedikt Dyrlich, Olga Xirinacs Díaz, Dan Dănilă, David Ebershoff, Horst Eckert, Jennifer Egan, Jari Ehrnrooth, Lizzie Eldridge, Menna Elfyn, Ayeshah Emon, Martin Enckell, Agneta Enckell, Michael Engler, Álvaro Enrigue, Markku Envall, Irjaleena Eriksson, Peter Lucas Erixon, Evgeny Ermolin, Victor Esipov, Paul Ewen, Belal Fadl, Daniel Falb, Maria Falikman, Elena Fanailova, Simon Ó Faoláin, Rafel Nadal Farreras, Sabina Fati, Lia Faur, Alexey Fedotov, Julian Fellowes, Betty Ferber, Ciara Ferguson, Viviana Fiorentino, Janet Fitch, Brid Fitzpatrick, Anne Fisher, Hana Fischer, Roman Fokin, Mathilde Fontanet, Assumpció Forcada, Sabine Forsblom, Tua Forsström, Fouad Fouad, David Francis, Julia Franck, Jonathan Franzen, Bashabi Fraser, Maureen Freely, Frederike Frei, Uwe Friesel, Anna Friman, Angela Furtună, Rita Gabis, Linda Gaboriau, Maria Galina, Mia Gallagher, Sergei Gandlevsky, Alisa Ganieva, Josep Rafel Cortés Garcia, Dominique Gaucher, Liliya Gazizova, Carlo Gebler, Eva Gedin, Stefan Gemmel, Alexander Genis, Nina George, Clive Geraghty, Yaseen Ghaleb, Rania Ghandour, Radu Pavel Gheo, Carmen Gheorghe, Cătălin Ghiță, Áíne Ní Ghlinn, Áine Ní Ghlinn, Bernard Gilbert, Shauna Gilligan, Daithí Mac Giobúin, Jo Glanville, Jacques T. Godbout, Peter H. E. Gogolin , Alex Goldiș, Francisco Goldman, Benjamin Goron, Philip Gourevitch, Fiona Graham, Bel Granya, Safer Grbić, Àngels Gregori, Mark Grinberg, Jean-Louis Grosmaire, Joakim Growth, Annett Gröschner, Ralph Grüneberger, July Gugolev, Xiaolu Guo, Kerstin Gustafsson, Çağdaş Gökbel, Tarık Günersel, Agnete G. Haaland, Gerda van de Haar, Katharina Hagena, Anna Katharina Hahn, Malu Halasa, Ena Katarina Haler, Denise Hamilton, Daniel Handler, James Hannaham, Linn Hansén, Heather Harlen, Lenore Hart, Tessa Harris, Dennis Haskell, Josef Haslinger, Harri Hautajärvi, Barend van der Have, Tom Healy, Jürgen Heckel, Carol Hedges, Siobhán Hegarty, Christoph Hein, Elke Heinemann, Markéta Hejkalová, Joachim Helfer, Elizabeth Hemmerdinger, Saara Henriksson, Alban Nikolai Herbst, Harri Hertell, Anna Heussaff, Kati Hiekkapelto, Judyth Hill, Sophia Hillan, Rinske Hillen, Elina Hirvonen, Elke Bannach-Hoffmann, Klaus Hoffmann W., Tom Hofland, Markku Hoikkala, Kaarina Hollo, Nina Honkanen, Laura Honkasalo, Ann Marie Hourihane, Dina Hrenciuc, Johanna Hulkko, Iman Humaydan, Jean-Claude Humbert, Franka Hummels, Vilja-Tuulia Huotarinen, Ramiz Huremagić, Jasmina Husanović, Eero Hämeenniemi, Severi Hämäri, Tomas Håkanson, Michael Hăulică, Florin Iaru, Omer Ibrahimagić, Nedžad Ibrahimović, Vasile Igna, Olga Ilnitskaya, Luuk Imhann, Almir Imširević, Jouni Inkala, Igor Irteniev, Tuula Isoniemi, Martti Issakainen, Päivi Istala, Houssam Itani, Andrei Ivanov, Natalya Ivanova, Victoria Ivleva, Oriol Izquierdo, Juliet Jacques, Alain Jadot, Subhash Jaireth, Claire Jaumain, Jennifer Jenkins, Angela V. John, Linton Kwesi Johnson, Thella Johnson, Kaylie Jones, Lois Jones, Michael Jordan, Huguette Junod, Wim Jurg, Anssi Järvinen, Pasi Ilmari Jääskeläinen, Elaine Kagan, Danson Kahyana, Gennady Kalashnikov, Kätlin Kaldmaa, Regina Kammerer, Arla Kanerva, Anneli Kanto, Entela Kasi, Markku Kaskela, Riina Katajavuori, Nina Katerli, Lucina Kathmann, Dražen Katunarić, Roni Nasir Kaya, Enver Kazaz, Helmi Kekkonen, Annu Kekäläinen, Jochen Kelter, Al Kennedy, Ligia Keșișian, Murat Kharaman, Igor Kharichev, Katarina Kieri, Malin Kivelä, Aino Kivi, Veronika Kivisilla, Margalith Kleijwegt, Mark Klenk, Snješka Knežević, Uwe Kolbe, Aljaž Koprivnikar, Nikolay Kononov, Tomi Kontio, Satu Koskimies, Conor Kostick, Igor Kotjuh, José Kozer, Gennady Krasukhin, Enrique Krauze, Irina Kravtsova, Marcella van der Kruk, Grigory Kruzhkov, Jan Kuhlbrodt, Asmir Kujović, Ilya Kukulin, Sergey Kuznetsov, Konstantin Küspert, Jorma Tapio Laakso, Oula-Antti Labba, David Lagercrantz, Jhumpa Lahiri, Olivia Laing, Michael Landgraf, Tanja Langer, Ksenia Larina, Felix M. Larkin, Ola Larsmo, Heike van Lawick, Eric Lax, Réaltán Ní Leannáin, Byddi Lee, Ion Bogdan Lefter, Joanne Leedom-Ackerman, Leena Lehtolainen, Eva Leipprand, Oleg Lekmanov, Lucia Leman, Jo Lendle, Andrea Lešić-Thomas, Ida Linde, Anne Linsel, My Lindelöf, Christoph Lindenmeyer, Fredy Rolando Ruilova Lituma, Zülfü Livaneli, Ruth Frances Long (Jessica Thorne), M.G. Lord, Gert Loschütz, Daniela Luca, Maria Ludkovskaja, Sofia Lundberg, Ulla-Lena Lundberg, Aki Luostarinen, Tom Lutz, Joris Luyendijk, Brendan Lynch, Irene Duffy Lyncy, Ruth Lysaght, Kristiina Lähde, Hélène Lépine, Adrian Lăcătuș, Michel Maas, Carl MacDougall, Chiara Macconi, Stuart Maconie, Kerry Madden, Dolors Coll Magrí, Sabrina Mahfouz, Inger-Maria Mahlke, Maria Maiofis, Geert Mak, Zvonko Maković, Christodoulos Makris, Jennifer Nansubuga Makumbi, Ștefan Manasia, Riri Sylvia Manor, Ksenija Banović Marković, Sarah Manvel, Laura Marchig, Rae Marie, Viorel Marineasa, Rudolf Marku, Frane Maroević, Iva Grgić Maroević, Lieke Marsman, Emile Martel, Jean-Pierre Masse, Marisa Matarazzo, Alexandru Matei, Ioan Matiuț, Edi Matić, Nicolaas Matsier, Manfred Maurenbrecher, Natalya Mavlevich, So Mayer, Daniel Mazzone, John C Mc Allister, Martina McAteer, Felicity McCall, Alistair McCartney, Paula McGrath, Lisa McInerney, Maria McManus, Elizabeth McSkeane, Paula Meehan, Vonne van der Meer, Maryse Meijer, Eva Menasse, Mooses Mentula, Bruno Mercier, Lluís Meseguer, Robin Messing, Katherine Mezzacappa, Bríd Ní Mhóráin, Peter Mickwitz, Susan Midalia, Virgil Mihaiu, Călin-Andrei Mihăilescu, Vanda Mikšić, Victoria Milescu, James Miller, Tim Miller, Lia Mills, Dolors Miquel, Ioana Miron, Sergey Mitrofanov, Jasim Mohamed, Clara Mohammed-Foucault, Núria Busquet Molist, Andreas Montag, Charles Montpetit, Carles Duarte I Montserrat, Laure Morali, Angel Martínez Moreno, Paul Morgan, Sinead Moriarty, Tony Morris, Ulli Moschen, Bertram Mourits, Ana María Dipp Mukled, Liridon Mulaj, Paul Muldoon, Marie-Ève Muller, Simon Mundy, Bogdan Munteanu, Seosamh Ó Murchú, Besnik Mustafaj, Carmen Mușat, Pekka J. Mäkelä, Ingrid Nachstern, Sten Nadolny, Azar Nafisi, Ralf Nestmeyer, Courttia Newland, Taciana Niadbaj, Ioana Nicolaie, Helmuth A. Niederle, Kai Nieminen, Jani Nieminen, Jaana Nikula, Georges Nivat, Celeste Ng, Mark Eliot Nuckols, Liz Nugent, Markus Nummi, William Nygaard, Konstantin Nökel, Barney Norris, Maxine Nunes, Nuala O’Connor, Lauren O’Donovan, Blanca Uzeta O’Leary, Vanessa Fox O’Loughlin, Fiona O’Rourke, Lev Oborin, Stipe Odak, Kurt Oesterle, Vida Ognjenovic, Ben Okri, Sofi Oksanen, Musa Okwonga, Emili Olcina, Lissa Oliver, Niculina Oprea, Zeynep Oral, Jem Cabanes Orriols, Julianne Ortale, Maxim Osipov, Mathias Ospelt, Tatiana Bonch-Osmolovskaya, Markus Ostermair, Georg M.Oswald, Willem Jan Otten, Jean-Luc Outers, Anton Antonov-Ovseenko, Eithne O’Donnell, Iduna Paalman, Markku Paasonen, Nina Paavolainen, George Packer, Vinyet Panyella, Rita Paqvalén, Alexey Parin, Serguei Parkhomenko, Leena Parkkinen, Alix Parodi, Tònia Passola,Vinay Patel, Nick Patricca, Cezar Paul-Bădescu, Jurica Pavičić, Alex Pearl, Michael Pearson, Daniel Gustafsson Pech, Daniel I. Pedreira, Gustaaf Peek, Riikka Pelo, Marianne Peltomaa, Mikko Perkoila, Cosmin Perța, Marta Pessarrodona, Dagmar Petrick, Dmitry Petrov, Heinrich Peuckmann, Lang-Hoan Pham, Louis-Karl Picard-Sioui, Emmanuel Pierrat, Asta Piiroinen, Drago Pilsel, Joan Manuel Pérez I Pinya, Daniel Pișcu, Andrey Plahov, Elisabeth Plessen, Thomas Podhostnik, Gregor Podlogar, Angelina Polonskaya, Antònia Carré-Pons, Simona Popescu, Liliana Popescu, Adrian Popescu, Edo Popović, Nenad Popović, Max Porter, Anja Portin, Tiina Poutanen, Kira Poutanen, David Poyer, Begonya Pozo, Kerstin Preiwuß, Vahidin Preljević, Jordi Prenafeta, Ahmet Prençi, Ofelia Prodan, Francine Prose, Alina Purcaru, Cezar Pârlog, Cathal Póirtéir, Shazea Quraishi, Verena Rabe, Mabrouk Rachedi, Tiina Raevaara, Arya Rajam, Selma Raljević, Karolina Ramqvist, Ian Rankin, Kukka Ranta, Jo-Ann Rasch-Hansen, Rein Raud, Daniela Rațiu, Steven Reigns, Mario Relich, Petra Reski, Monika Rinck, Ashley Rindsberg, Henrika Ringbom, Magnus Ringgren, Fanny del Rio, Peter Ripken, Jukka Rislakki, Simon Robinson, Josep Ballester Roca, Antonio della Rocca, Guenter G. Rodewald, Marc Granell Rodríguez, Manel Rodríguez-Castelló, Guido Rohm, Màrius Serra I Roig, Alexis Romay, Adrian G. Romila, Ville Ropponen, Adina Rosetti, Radu Sergiu Ruba, Lev Rubinstein, Evelina Rudan, Andreas Rumler, Maria Rybakova, Riku Räihä, Jan Röhnert, Hazem Saghieh, Kholod Saghir, Yassin Alhaj Saleh, Salajdin Saliu, Saad Salloum, Janne Salminen, Helena Pol Salvà, Gregor Sander, Paula Sanders, Ulrike Almut Sandig, Philippe Sands, Froukje Santing, Joachim Sartorius, Mark Sarvis John Ralston Saul, George Saunders, Jani Saxell, Simon Schama, Roswitha Schieb, Regina Schleheck, Samantha Schnee, Peter Schneider, Ralph Schock, Eugene Schoulgin, Jutta Schubert, Christa Schuenke, Martin Schult, Tom Schulz, Hermann Schulz, Erik Schumacher, Elmer Schönberger, Stefan Schütz, Marjan Strojan, Gert Scobel, Alice Sebold, Olga Sedakova, Lindsay J. Sedgwick, Gabriel Seisdedos, Krishna Sen, Séadna Mac Seoin, Seid Serdarević, Ellen Severance, Keyvan Shahbazi, Amir Shaheen, Flamur Shala, Paata Shamugia, Tatyana Shcherbina, Róisín Sheehy, Owen Sheers, Viktor Shenderovich, Peter Sheridan, Alla Shevelkina, Mikhail Shishkin, Paul Anthony Shortt, Gary Shteyngart, Arkady Shtypel, Nikesh Shukla, Niall Ó Siadhail, Kertu Sillaste, Marisa Silver, Goran Simić, Sherry Simon, Jonathan Simons, Helena Sinervo, Viveka Sjögren, Jane Smiley, Barbara Smitmans-Vajda, Gerard Smyth, Slobodan Snajder, Timothy Snyder, Catalina Sojos, Boris Sokolov, Natalia Sokolovskaya, María Soliva, Leela Soma, Rosa I Sabater, Jasna Šamić, Ivan Šarčević, Andrew Solomon, Simona Sora, Sanja Šoštarić, Vladimir Sotnikov, Tatyana Anna Berseneva Sotnikova, Ralf Sotscheck, Matthew Sprecktor, Art Spiegelman, Monica Spiridon, Klaus Staeck, Irina Staf, Dmitry Stakhov, Dan Stanciu, Saša Stanišić, Laura Starink, Kjersti Løken Stavrum, Deborah Stein, Eira Stenberg, Cecilia Ștefănescu, Wilhelm von Sternburg, Vidosav Stevanović, Caroline Stockford, Jürgen Streich, Tina Stroheker, Antje Rávik Strubel, Lucija Stupica, Bogdan-Alexandru Stănescu, Leander Sukov, Francoise Sule, Anni Sumari, Lubov Summ, Irina Surat, Ville-Juhani Sutinen, Slobodan Šnajder, Zoya Svetova, Hannele Mikaela Taivassalo, Eeva Talvikallio, Amy Tan, Anne Tannam, Stefanie Taschinski, Elma Tataragić, Anne-Marie Tatsis, Marion Tauschwitz, Henriikka Tavi, Catherine Taylor, Danielle Thibault, Ma Thida, Hans Thill, France Théoret, Susan Tiberghien, Mika Tiirinen, Lev Timofeev, Alan Titley, Gráinne Tobin, Salimata Togora, Colm Toibin, Miia Toivio, Csilla Toldy, Steve Toltz, Carles Torner, Larry Tremblay, Andreas Tretner, Salil Tripathi, Ilija Trojanow, Agron Tufa, Kári Tulinius, Tanja Tuma, Natalya Tumashkova, Veera Tyhtilä, Frank Überall, Dolors Udina, Liudmila Ulitskaya, Radu Ulmeanu, Manon Uphoff, Doina Uricariu, Lluís I-Jovani Urpinell, Luis Alberto Urrea, Urtzi Urrutikoetxea, Anja Utler, Damir Uzunović, Luisa Valenzuela, Tina Vallès, May VanDuren, Radu Vancu, Dragoș Varga, Johanna Vehkoo, Xavier Velasco, Dragan Velikić, Johanna Venho, Regula Venske, Xavier Vernetta, Laurence Verrey, Maarit Verronen, Lidia Vianu, Hoàng Nguyen Bao Viet, Félix Villeneuve, Marina Vishnevetskaya, Carolijn Visser, Alina Vituhnovskaya, Maria Vlaar, Călin Vlasie, Elena Vlădăreanu, Tatiana Voltskaya, Marja Vuijsje, Smaranda Vultur, Carlos Vásconez, Jan Wagner, Ayelet Waldman, Geneviève Waldmann, Maybelle Wallis, Katri Wanner-Salmi, Andrea Ward, Rainer Wedler, Lisa Weeda, Gabriele Weingartner, Thomas Weiß, Annamaria Weldon, Benedict Wells, Hanna Weselius, Taina West, Caj Westerberg, Tara Westover, Kjell Westö, Mårten Westö, Eva Wiesenecker, Herbert Wiesner, Renate Wiggershaus, Eley Williams, Jeni Williams, Rita Williams, Laurie Winer, Marion Wisinger, Uljana Wolf, Tobias Wolff, Máire Dinny Wren, Françoise Wuilmart, Christine Wunnicke, Marina Yadrova, Sergey Yakovich, Elena Yakovich, Alexander Yarin, Viktor Yaroshenko, Samar Yazbek, Charles Yu, Elvana Zaimi, Judith Zander, Andrei Zbîrnea, Michael Zeller, Joachim Zelter, Myra Zepf, Cornelia Zetzsche, Sophie Zijlstra, Clas Zilliacus, Harro Zimmermann, Igor Zotov, Matthias Zwarg, Celia de Fréine, Oek de Jong, Stéphanie de Roguin, Edmund de Waal, Kit De Waal Antonije Nino Žalica, Emina Žuna.
المدن
—————————
الحرب الروسية على أوكرانيا: إسرائيل تغازل الغرب ولا تريد إغضاب بوتين/ مصطفى إبراهيم
ينطلق الحذر الإسرائيلي من عدم رغبتها في استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، كي لا تضطر إلى الاختيار بين الولايات المتحدة وروسيا، وهذا ما تخشاه ولا ترغب به.
ترتبط إسرائيل بعلاقات متشابكة مع روسيا وأوكرانيا، تحكمها مصالح اقتصادية وأمنية، إذ تحاول إسرائيل الحفاظ على الهدوء والحذر بخيط رفيع بين هذه العلاقات، بخاصة مع روسيا التي تؤمن لها حرية الحركة في الأجواء والأراضي السورية، لكنها أيضاً لا يمكن أن تتجاهل العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية.
إسرائيل تعتبر نفسها من دول العالم الحر، وترى أنها حليف استراتيجي للغرب بزعامة الولايات المتحدة، وفي وسط هذه العلاقات وتشابك المصالح، يعيش عشرات آلاف الإسرائيليين، إلى مئات آلاف اليهود في روسيا وأوكرانيا، وكما قال وزير الخارجية يائير لبيد فإن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم “في مقدمة اعتباراتنا”.
تبدو إسرائيل حذرة، وتتجنب استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رغم إدانتها الغزو الروسي لأوكرانيا وتضامنها مع الأخيرة، إذ امتنع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، عن التنديد بروسيا في أعقاب شنها الحرب على أوكرانيا. وقال: “هذه فترة صعبة وتراجيدية، وقلبنا مع مواطني أوكرانيا الذين علقوا في وضع كهذا من دون اقتراف أي ذنب”. وأضاف، “إسرائيل تقف في هذه الأيام تحديداً كمرساة قوة واستقرار وأمن وأمل، في منطقة صعبة، تملأها التهديدات والتحديات. وأي إسرائيلي يعلم دائماً أن لديه بيتاً يعود إليه، وأن هناك من يهتم به أثناء المصيبة”.
في الوقت نفسه، لم يخف إسرائيليون تضامنهم مع أوكرانيا، إذ أسهبت وسائل الإعلام العبرية ومقدمو البرامج التلفزيونية والإذاعية، في عكس حجم التضامن، انطلاقاً من معرفتهم بمعنى الحرب والخوف والرعب واستحضار صور الأوكرانيين في نفق المترو والملاجئ والصواريخ فوق رؤوسهم!
مقاربة فيها الكثير من الازدواجية في التعامل الأخلاقي، خصوصاً لجهة تجاهل أن إسرائيل هي منظومة احتلال استعماري استيطاني ومنظومة فصل عنصري، ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
عام 2014، تغيبت إسرائيل عن التصويت في الجمعية العامة لإدانة احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، بذريعة إضراب موظفي وزارة الخارجية، على رغم الضغط الأميركي.
ينطلق الحذر الإسرائيلي من عدم رغبتها في استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، كي لا تضطر إلى الاختيار بين الولايات المتحدة وروسيا، وهذا ما تخشاه ولا ترغب به.
والمتابع للأحداث قبل بدء الغزو الروسي، يلاحظ الدعوات الإسرائيلية للطرفين الروسي والأوكراني إلى التفاوض والاحتكام للسلم والمفاوضات، وحافظت إسرائيل على هذا الموقف حتى إعلان الرئيس الروسي الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك كإقليمين مستقلين عن أوكرانيا. ومع بدء العملية العسكرية الروسية لم تصمد أمام عدم قدرتها على إدانة روسيا، حتى من دون أن تطلب منها أوكرانيا، وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية.
إسرائيل تعتبر نفسها جزءاً من الغرب والعالم الحر الديموقراطي، ومن الطبيعي وفق رؤيتها لنفسها أن تكون ضمن هذا العالم المفترض، وهي مضطرة أن تسير خلف حليفتها الولايات المتحدة وحلف الناتو، مع أنها ليست عضوة فيه.
خلال السنوات الماضية منذ عام 2015، بعد تدخل روسيا العسكري في سوريا وسحقها معارضي النظام، وتمكين بشار الأسد من استعادة مناطق عدة، تعمقت العلاقات الإسرائيلية- الروسية بشكل كبير.
تربط الإسرائيليين والروس علاقات قوية بخاصة في المجال الأمني لمواجهة الوجود الإيراني و”حزب الله” على حدود إسرائيل الشمالية.
تم الاتفاق على ترتيبات أمنية بين الطرفين، وقدمت روسيا لإسرائيل تطمينات بعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي السورية ضد تل أبيب.
عملياً، لم يقدم أحد خدمة لإسرائيل كما فعلت روسيا التي منحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضمانات أمنية وحرية الحركة في المجال الجوي السوري.
في اليوم الأول للغزو الروسي لأوكرانيا، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجمات ضد أهداف سورية وقتل عدد من الجنود السوريين، ومنذ ذلك الوقت تعتبر حدود إسرائيل هي ذاتها حدود روسية.
ووفقاً لمحلل إسرائيلي فإن إسرائيل تسير بين القطارات، وهذا ما ظهر في موقفها الرسمي، المعلن، تجاه الصراع الروسي- الأوكراني. بعد كل شيء، لن يكون الأمر مستغرباً في حال لم يحرف الرئيس بوتين الطائرات المقاتلة الروسية عن مساراتها في الأجواء السورية.
إسرائيل تسعى إلى عدم إغضاب روسيا، وتحاول أن تبقى على الحياد في هذه الحرب التي لا ترغب بأن تكون فيها مع طرف ضد آخر، وتحاول التمهّل إزاء الصراع القائم بين الولايات المتحدة وروسيا، لا سيما في ظل تطور العلاقات بين إسرائيل وروسيا في السنوات الماضية سياسياً واقتصادياً، وتبادل الخبرات العسكرية، وهذا ما يجعل إسرائيل أكثر حذراً في الاصطفاف لمصلحة طرف من طرفي الصراع.
هذا الحذر، قد لا يطول، وقد تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى اتخاذ موقف من الحرب، فالضغط الأميركي مستمر، كما أنها ترتبط وأوكرانيا بعلاقات أمنية وتكنولوجية واقتصادية، إضافة إلى أن أوكرانيا جزء من دول شرق أوروبا التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، هذه الدول أكثر قرباً من إسرائيل وتعاطفاً معها، ومنها أوكرانيا وحتى روسيا، لأسباب مختلفة.
إسرائيل تدرك ماذا تريد، وذلك انطلاقاً من مصالحها وكيفية الحفاظ عليها، والحذر نابع من ذلك، وهي لن تتردد في لعب دور الضحية ودور الذئب، وعليه سيكون موقفها نابعاً من ذلك، وقدرتها على اتخاذ موقف عدم الاصطفاف مع طرف على حساب آخر، على رغم إدانتها الغزو الروسي على أوكرانيا واعتبارها إياه انتهاكاً.
حتى إنها قد تلعب دور الوساطة في الأزمة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب في اتصال هاتفي مع نفتالي بينت أن يتوسط مع روسيا من أجل وقف الحرب، زيلينسكي يؤمن أن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة التي لها علاقات ممتازة مع أوكرانيا ومع روسيا، تؤهلها للعب دور الوسيط.
يبدو أن إسرائيل تدرك أن هذه الحرب قد لا تحدث تغييراً جدياً في النظام العالمي، وهي لا تريد هذا التغيير، كما أنها لا تريد هذه الحرب وترغب في وقفها، حتى لا تجد نفسها مضطرة للوقوف في صف حليفتها الولايات المتحدة الأميركية ضد روسيا. فإلى متى يستمر الحياد الإسرائيلي؟
درج
—————————
التايمز: هكذا أحبطت المقاومة الأوكرانية خطة بوتين لتحقيق الانتصار بغضون 48 ساعة
قالت مصادر دفاعية بريطانية وأوكرانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتقد أنه سيتمكّن من الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف، وما يصل إلى أربع مدن أخرى في أوكرانيا بغضون 48 ساعة من بدء هجومه، لكن موسكو تفاجأت بالمقاومة الأوكرانية.
صحيفة The Times البريطانية التي نقلت عن مصادر عدة، قالت الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، إن مصدراً عسكرياً زعم بأن “الخطة كانت أن يستسلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتوقيع على تسليم بلاده لروسيا في دير بيشيرسك لافرا التاريخي، الذي زاره بوتين في عام 2004″.
لكن مع ذلك، لم تُسِر حربه كما هو مخطط لها، إذ واجهت القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة، وأشار المحللون إلى إخفاقات في التكتيكات العسكرية الأساسية وغياب الروح المعنوية.
نقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأوكراني دميترو تريتياكوف، وهو السكرتير الأول في السفارة في لندن، قوله إنَّ “تقدم روسيا كان أبطأ من المتوقع لأنَّ هذه أرضنا وعائلاتنا ومنازلنا”. وأضاف أنَّ “الشعب والجيش الأوكرانيين، بدعم من الحلفاء لا يخافون ولا يشعرون بالذعر”، بحسب تعبيره.
كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت عن إسقاط طائرات حربية روسية من طراز “سو-30” وطائرات نقل عسكرية، وفجّرت عشرات الدبابات ومئات المركبات المدرعة وأسقطت صواريخ كروز، وفي المقابل أعلنت موسكو عن تدمير المئات من البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا.
استهداف الدبابات الروسية
تجاوز ذلك التوقعات الروسية، وتسبب بإرباك للمراقبين وحتى الخبراء العسكريين الغربيين “لأن أوكرانيا منعت روسيا من السيطرة على المجال الجوي، وحرمت بوتين من أهدافه الاستراتيجية الأولية”، بحسب الصحيفة.
فعلى الرغم من أنَّ الجيش الأوكراني صغير مقارنة بالجيش الروسي – بقوام 196600 جندي مقابل 900000 جندي- إلا أنه من الحقائق العسكرية البديهية أنه يتطلب ثلاث أو أربع وحدات مهاجمة لهزيمة وحدة دفاعية واحدة.
في هذا الصدد، قال مصدر بالجيش البريطاني للصحيفة: “إذا كنت تريد مهاجمة فصيلة، فأنت بحاجة إلى شركة”، ونقلت The Times عن مصدر عسكري آخر قوله إن “الدبابات تتجه على ما يبدو إلى القرى غير مدعومة- بدون عربات مدرعة وجنود مشاة- مما يسهل على القوات الأوكرانية مهاجمتها”.
أشار المصدر نفسه إلى أن “حقيقة رسم الروس علامات مجموعة قتالية بيضاء، بما في ذلك الأحرف “Z” و “V” على الدروع، جعلت التعرف عليهم أسهل”.
بحسب الصحيفة البريطانية أيضاً، فإن الروح المعنوية أثرت على الروس في أوكرانيا، وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس الأسبوع الماضي، إن البعض “إما وقعوا في الأسر، أو هجروا مناصبهم بمجرد أن اكتشفوا أنَّ العملية لم تكن مثلما اعتقدوا”.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أوكرانية، قولها إنه في “الطريق إلى تشيرنيغوف في الشمال تخلت عدة وحدات عن مركباتها وتراجعت بسبب نفاد الوقود”، وتحدث مصدر آخر أنَّ “القوات الروسية تتوسل أيضاً للسكان للحصول على الطعام في بعض الأماكن”، بحسب قوله.
مقاومة “أقوى” من المتوقع
كيفن برايس، وهو جنرال سابق في الجيش البريطاني، قال إنَّ اللقطات المنشورة على الشبكات الاجتماعية، تُشير إلى أنَّ الأوكرانيين نقلوا طائراتهم المقاتلة القديمة إلى مواقع عشوائية في جميع أنحاء البلاد، بحيث لا تتعرض العديد منها للتفجير في العملية الروسية الأولية لتدمير الحقول الجوية.
بدوره، قال جاستن كرامب، من شركة Sibylline، وهي شركة استخباراتية ومخاطر جيوسياسية، ومحارب قديم في الجيش، إنَّ “المقاومة الأوكرانية كانت أقسى مما كان متوقعاً، إذ كان الأوكرانيون يقاتلون ببراعة في بعض الأماكن وحرموا الروس من استخدام الجسور والسكك الحديدية”.
أضاف كرامب أنه “من المحتمل أن يتحرك الروس الآن للتعامل مع السكان باعتبارهم أهدافاً عادلة”، مضيفاً أنهم ربما يفكرون في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ولديهم “قنابل فراغ” حرارية في جعبتهم. وقال إنَّ 20 إلى 30 طائرة أوكرانية لا تزال نشطة لم تكن كافية لتغيير دفة القتال.
في هذا السياق، حذّر مسؤولون غربيون في الأسبوع الماضي، من أنَّ بوتين سيكون على استعداد للجوء إلى “أي وسيلة ضرورية” لكسب الحرب.
خسائر الحرب
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد 27 فبراير/شباط 2022، عن “تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية”، منذ يوم الخميس 24 فبراير/شباط 2022.
الوزارة أفادت في بيان، بأن قواتها شنت خلال أمس الأول السبت، ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
أوضح البيان أن بين المنشآت المستهدفة في أوكرانيا “23 نقطة تحكُّم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية، و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات، و48 محطة رادار”، بحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول”.
من جانبها، أعلنت أوكرانيا الأحد 27 فبراير/شباط 2022، على لسان نائبة وزير الدفاع، هنا ماليار، أن “القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا”، وأضافت على صفحتها في فيسبوك أن روسيا “فقدت نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر”، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
————————-
الهجوم الروسي على أوكرانيا.. هل سقط فلاديمير بوتين في “فخ غربي” هدفه استنزاف روسيا؟
عربي بوست
الهجوم الروسي على أوكرانيا دخل يومه الخامس دون أن تتضح ملامح حسم عسكري أو اتفاق سياسي، فهل سقط الرئيس فلاديمير بوتين في “فخ” غربي على الأراضي الأوكرانية؟
كان الهجوم على أوكرانيا قد بدأ فجر الخميس، 24 فبراير/شباط، فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “عملية عسكرية هدفها منع عسكرة أوكرانيا”، بينما تصف أوكرانيا والغرب ذلك بأنه عدوان روسي هدفه الغزو الشامل للأراضي الأوكرانية وإسقاط الحكومة، وتنصيب حكومة مطيعة لموسكو.
ولم يكن الهجوم الروسي مفاجئاً لا لأوكرانيا ولا للغرب ولا للعالم، فالأزمة الأوكرانية مشتعلة منذ عام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعمت حركات انفصالية في دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا، وكان اعتراف موسكو بتلك المناطق مقدمة للعملية العسكرية، التي أصبحت حرباً شاملة بالفعل.
والأزمة الأوكرانية هي بالأساس أزمة جيوسياسية تتعلق برغبة الحكومة الأوكرانية- المدعومة من الغرب- الانضمام لحلف الناتو، بينما تعتبر روسيا ذلك خطاً أحمر، لأنه يمثل تهديداً مباشراً لأمنها، بحسب وجهة النظر الروسية.
ماذا حقق الروس على الأرض؟
عندما بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، كانت السيناريوهات المتوقعة عملياتياً على الأرض هي إما مساعدة الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك على اختراق خط التماس والسيطرة تماماً على إقليم دونباس بالكامل، حيث كان يسيطر الانفصاليون على 32% من مساحة الإقليم، ومن ثم يعلن الانفصاليون الرغبة في الانضمام لروسيا، وهو السيناريو الذي نفذه بوتين عام 2014 في شبه جزيرة القرم، مع اختلاف جوهري، هو أن الانفصاليين الأوكران المدعومين من روسيا سيطروا على الإقليم بالكامل دون قتال تقريباً من جانب الجيش الأوكراني.
وعلى الرغم من أن “التدخل الروسي” شمل منذ اللحظة الأولى استهدافاً للقواعد العسكرية والدفاعات الجوية الأوكرانية في العاصمة كييف وخاركييف ثاني أكبر المدن وأوديسا أيضاً وهي ثالث أكبر المدن وباقي المدن الأوكرانية، إلا أن بعض الخبراء قالوا إن ذلك يهدف فقط إلى شل قدرة الوحدات العسكرية في دونباس على القتال، ومن ثم الاستسلام وانتهاء المهمة سريعاً بسيطرة الانفصاليين على الإقليم.
لكن عملية السيطرة على أحد أكبر المطارات الأوكرانية في ضواحي كييف وإنزال أرتال من الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود الروس أظهر، بحسب كثير من المحللين والخبراء العسكريين، أن ما يحدث هو سيناريو “قطع الرأس”، أي الإطاحة بالحكومة الأوكرانية برئاسة فولوديمير زيلينسكي، الذي تصفه موسكو بأنه “دمية” في يد الغرب وواشنطن تحديداً وينفذ أجندتهم لحصار روسيا.
أوكرانيا
ومع مرور اليوم الرابع من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا تزال الأمور العسكرية على الأرض غير واضحة، وهناك تباين ضخم بين ما تعلنه كييف وما تقوله موسكو بشأن سير العمليات العسكرية والخسائر التي يتكبدها كل طرف، وتزامن هذا الغموض مع بداية مفاوضات بين الجانبين على الحدود البيلاروسية، دون أن يكون واضحاً كذلك الغرض من تلك المفاوضات.
وكان قرار بوتين الأحد 27 فبراير/شباط وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى قد أثار تساؤلات بشأن دوافعه من وراء تلك الخطوة التصعيدية، التي قال الرئيس الروسي إنها تأتي رداً على التصريحات العدائية من جانب مسؤولين في حلف الناتو تجاه موسكو. فهل كان ذلك رسالة تهديد للغرب أم إحباط من الفشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا أم مجرد تصعيد ينم عن التحدي؟
وعلى الرغم من أن متحدثاً باسم مجلس الوزراء البريطاني نقل عن زيلينسكي قوله لرئيس الوزراء بوريس جونسون الأحد بأن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، إلا أنه من الصعب القول إن الهجوم الروسي قد حقق انتصارات كبيرة أو ملموسة حتى يومه الخامس.
هل فشلت خطط بوتين أم أنها لم تبدأ بعد؟
أربعة أو خمسة أيام أو أسبوع أو أسبوعان أو حتى شهر قد لا تمثل بعداً زمنياً طويلاً في الحروب والصراعات والأزمات، وبالتالي الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن هو أن الوقت لا يزال مبكراً لإصدار أحكام بشأن ما قد تؤول إليه تلك الحرب، التي تمثل حرب المعلومات جانباً أساسياً فيها. وفي ظل الاستقطاب الهائل الذي يسود العالم حالياً، حتى على مستوى التغطية الإعلامية، سيظل من الصعوبة بمكان الخروج بتحليلات وتكهنات دقيقة.
لكن في ظل ما هو متاح من معلومات حتى الآن، يمكن القول إن أهداف العملية العسكرية أو الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما جاءت على لسان بوتين “منع عسكرة أوكرانيا”، تتخطى بشكل واضح إقليم دونباس وتشمل السيطرة على البلاد بشكل كامل، لكن لا أحد لديه إجابة عن السؤال المنطقي في هذه الحالة وهو “ماذا بعد؟”
ويرى أغلب المحللين الغربيين أن بوتين “أخطأ في حساباته العسكرية واستهان بقوة وإرادة الجيش والشعب الأوكرانيين”، وهذا هو سبب “فشل الهجوم الروسي على أوكرانيا في تحقيق أي من أهدافه حتى الآن”، وذلك بحسب تحليل لموقع Vox الأمريكي عنوانه “استراتيجية بوتين الحربية مرتبكة”.
رئيس أوكرانيا زيلينسكي روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي – رويترز
كما قال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز إن روسيا أطلقت أكثر من 350 صاروخاً على أهداف أوكرانية حتى الآن بعضها أصاب البنية التحتية المدنية، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “يبدو أنهم يتبنون عقلية الحصار التي سيقولها لك أي طالب يدرس الأساليب والاستراتيجيات العسكرية.. عندما تتبنى أساليب الحصار فهي تزيد من احتمالية حدوث أضرار جانبية”.
واستشهد المسؤول الأمريكي بهجوم روسي على مدينة تشيرنيف شمال كييف حيث قالت السلطات الأوكرانية إن النيران اشتعلت في مبنى سكني بعد إصابته بصاروخ في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بينما ذكرت قيادة القوات البرية الأوكرانية أن مدينة زوتيمر في شمال أوكرانيا تعرضت لهجمات بالصواريخ خلال الليل.
وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا لم تسيطر على أي مدينة أوكرانية ولا على المجال الجوي الأوكراني ولا تزال قواتها على بعد حوالي 30 كيلومتراً من وسط مدينة كييف لليوم الثاني.
لكن هناك جانب آخر من الصورة، بحسب فريق آخر من المحللين، يقول إن القوات الروسية قد حققت أهدافها من العملية العسكرية بدقة حتى اليوم الرابع، وإن تلك القوات تقوم الآن بتحييد الدفاعات الأوكرانية والسيطرة على قواعد ونقاط ارتكاز حول المدن الأوكرانية الرئيسية وهو ما تحقق بالفعل، استعداداً للمرحلة الثانية من العملية وهي السيطرة على المدن.
ويبرر الجانب الروسي التحرك البطيء لقواته في محيط المدن الأوكرانية بالرغبة في تجنب الخسائر بين المدنيين، بينما تتهم السلطات الأوكرانية “العدو الروسي” باستهداف المناطق السكنية وتعمد استهداف المباني السكنية، وهذه الروايات المتناقضة تصب في خانة حرب المعلومات التي تزداد حدتها وقت الحرب.
هل تتحول أوكرانيا إلى “مستنقع” لاستنزاف روسيا؟
هناك عدة معطيات برزت خلال الأيام الأربعة الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا من المهم أخذها في الحسبان عند محاولة استقراء مسار الحرب وما قد تؤول إليه في نهاية المطاف. من هذه المعطيات العقوبات الاقتصادية الضخمة التي فرضها الغرب، وبخاصة موقف ألمانيا وتعليق خط أنابيب الغاز وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، رغم أن الانقسام في الموقف الغربي كان موجوداً بوضوح قبل بدء الهجوم الروسي.
العامل الآخر هو دعوة الرئيس الأوكراني لتشكيل “فيلق دولي” للدفاع عن كييف والتشجيع العلني من عواصم غربية لهذا التوجه، كما فعلت وزيرة الخارجية البريطانية، إذ يبدو أن هذه الدعوة ستكون باباً خلفياً لإرسال مرتزقة ومسلحين إلى أوكرانيا لقتال الروس، بحسب خبراء عسكريين ومحللين. فالغرب يتفادى إرسال قوات نظامية إلى أوكرانيا؛ لأن ذلك معناه حرب عالمية، لكن إرسال متطوعين تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني قد يكون أمراً لا يستطيع الروس أن يلصقوه بالغرب.
ونشرت صحيفة Daily Mail البريطانية بالفعل تقريراً بعنوان “60 متطوعاً بريطانياً يتوجهون إلى أوكرانيا لمواجهة غزاة بوتين”، ورصد التقرير أن المتطوعين عبارة عن عسكريين سابقين خدموا في الجيش والقوات الخاصة البريطانية.
لكن ربما يكون العامل الأكثر خطورة وتهديداً لبوتين هو الاحتجاجات الداخلية على قرار الهجوم على أوكرانيا، وقد صدرت بالفعل تعليمات مشددة في روسيا تهدد من يخرج للتظاهر ضد العملية العسكرية في أوكرانيا بالسجن لمدة 20 عاماً، وبالتالي فإن طول المدى الزمني للحرب في أوكرانيا وظهور تداعيات سلبية للعقوبات الاقتصادية يهدد تماسك الجبهة الداخلية الروسية.
تقارير غربية تقول إن روسيا نشرت صواريخها الحراراية في أوكرانيا
وإضافة إلى تلك العوامل هناك أيضاً التعاطف الدولي المتزايد مع المدنيين الأوكرانيين والتغطية الإعلامية الغربية المكثفة لذلك الجانب الإنساني وإظهار روسيا في صورة الدولة النازية التي تسعى لالتهام دولة ديمقراطية في أوروبا، وهو الجانب الذي لن تستطيع فيه روسيا مجاراة السردية الغربية، وبالتالي تزيد كل هذه العوامل من عزلة روسيا وتصب في خانة وقوع بوتين في “فخ غربي” على الأراضي الأوكرانية هدفه استنزاف روسيا.
لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يكمل أسبوعه الأول، ولم يظهر في ساحة المعركة أي من الأسلحة الروسية المرعبة كالقنابل الفراغية أو الصواريخ الحرارية وغيرهما، مما يعني أنه من المبكر تماماً الجزم بأن الروس غير قادرين على السيطرة على أوكرانيا عسكرياً، كما قال ميسون كلارك المحلل الروسي في معهد دراسة الحرب بواشنطن لموقع Vox الأمريكي.
وفي الوقت نفسه لا تزال المفاوضات بين موسكو وكييف واردة ومجالها مفتوحاً وانطلقت بالفعل الإثنين على الحدود البيلاروسية، رغم أن الرئيس الأوكراني كان قد رفض الأحد التفاوض على أراضي بلياروسيا التي تقف مع روسيا، وأصر على أن تقام المفاوضات في تركيا أو بولندا أو أذربيجان. كما أن الروس من جانبهم وافقوا على التفاوض، دون شروط وهي بادرة جيدة، لكن بشكل عام من الصعب تصور نجاح تلك المفاوضات في إنهاء العملية العسكرية الروسية، اللهم إلا إذا وافق زيلينسكي على الاستقالة من منصبه وهو أمر مستبعد تماماً في ظل رفض الرئيس الأوكراني عرضاً أمريكياً بمغادرة البلاد خوفاً من الوقوع أسيراً لدى الروس.
الخلاصة هنا أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة ما إذا كان الرئيس الروسي قد سقط في “فخ أوكراني” نصبه له الغرب بغرض استنزاف روسيا دون الدخول في حرب مباشرة معها، أم إذا ما كان بوتين قد قرر أنه آن الأوان لتحدي ما يراه هيمنة أمريكية على النظام العالمي.
——————————

العقيدة الأوراسية والحرب المصيرية/ طالب الدغيم
لا أريد الإكثار من التنظير والتكهن حول تداعيات وآثار الغزو الروسي لأوكرانيا؛ دولة الجوار والتوأم التاريخي، بمجالها الترابي، وتنوعها الإثني، وغناها بالموارد الطبيعية، وخصوصية قوانينها وقِيمها الوطنية، وتقدم إنتاجها التكنولوجي والصناعي والعلمي والثقافي، واختلاف بُنيتها وتحالفاتها السياسية الخارجية عن روسيا في وقتنا الراهن، وانعكاسات الحدث المدوي على العلاقات بين الدول في شرق العالم وغربه، غير أن مواكبة هذا التطور العسكري عبر رصد وقائع التاريخ وظواهر التبدل الحضاري في إطار الفلسفة الخلدونية للتاريخ، وطروحات المؤرخ الألماني شبنغلر عن تعاقب الدورة الحضارية للأمم والإمبراطوريات (طفولة، فتوة، شيخوخة)، هو من أبرز أدوات المؤرخ في قراءة وتدوين هذا الحدث.
العقيدة الأوراسية (مخ بوتين)
ظلت الجغرافيا الكلمة السرية الدائمة في الاستراتيجية الروسية (الجيوبوليتيك الدفاعي) قديماً وحديثاً؛ ولهذا فقد آمن الزعماء الروس في كل مراحل تاريخهم بالتفكير الإمبريالي لتحييد التهديدات داخل الفضاء الأوراسي (أوراسيا في الخرائط الروسية تشمل القارة الأوروبية والآسيوية بما فيها أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط بمساحة تتجاوز 54 مليون كم2)، ونظروا إلى القِيم الغربية الليبرالية والاقتصاد المفتوح على أنه مقدمات لخطرٍ يهدد كيانهم، وسعوا دائماً لبناء نظام اجتماعي وسياسي ذاتي يمنح الدولة قدرة الدفاع عن مصالحها وكبح الاعتداءات الخارجية. وشارك في ذلك التخطيط مفكرون روس أسسوا ما سموه “المدرسة الجيوبوليتيكية”، ويعتبر الرائد الأكبر لها هو صديق بوتين المقرب المفكر الروسي ألكسندر دوغين، والذي صدر له كتاب عام 1998 تحت عنوان “أسس الجيوبوليتيكا (مستقبل روسيا الجيوبولتيكي)”، وشهد رواجاً وتُرجم لعدة لغات عالمية بما فيها العربية، وعمل دوغين مستشاراً في مجلس الدوما الروسي حتى عام 2003، وشغل منصب رئيس مجلس خبراء الجيوبوليتيكا للأمن القومي الروسي بعد ذلك.
انصب اهتمام بوتين منذ توليه الحكم في الكرملين عام 2000م، على النطاق الأوراسي حسب الجغرافي البريطاني هالفورد ماكيندر، فالمشروع القيصري، حسب ماكيندر، يربط موسكو عبر دوائر متداخلة بالدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وتكون أولى حلقاتها دول الاتحاد السوفييتي السابق؛ بوصفها منطقة نفوذ خالصة لروسيا أمام التمدد الغربي، من خلال عقد شراكات وثيقة، وفرض نفوذ اقتصادي وسياسي وأمني على الدول التي تشاركها الحدود، أو التدخل عسكرياً عند اللزوم، كما حدث في جورجيا والقرم وأوكرانيا، أو أبعد من ذلك كما في سوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى…
رأى أنصار المشروع الأوراسي بأن الحضارة الغربية متعثرة ولا تمثل مشتركات بشرية حضارية، وكل محاولاتها للتحديث والنهضة تسير وفق مصالح غربية تقوض إرادة الدول المتوسطة والصغيرة، وتستغل حاجاتها وتستنزف مواردها. وهذا المشروع حامله عقيدة الرجل القيصر الذي يسعى برؤيته الإمبراطورية وعقيدته الأمنية حسب ما تقول المسؤولة السابقة في المخابرات الوطنية الأميركية والباحثة في معهد بروكينغز “أنجيلا ستنت” في تحليل نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأميركية بتاريخ 24 فبراير 2022: “بوتين رأى الوقت مواتياً للتحرك، وبرأيه، الولايات المتحدة منقسمة في سياستها الخارجية ولدى الأوروبيين تحديات داخلية”، فيما تمتلك روسيا سطوة معتبرة في دول الاتحاد السوفييتي السابقة وداخل القارة الأوروبية، بفضل استراتيجية الطاقة التي تغذي العالم، والردع العسكري بإعلانه عن منظومات صاروخية فوق صوتية قادرة على إهلاك أي دولة على الأرض، أضف لذلك، ثقة الحلفاء بروسيا، وعضويتها في مجلس الأمن الدولي.
كرر بوتين بأن روسيا من حقها استخدام القوة إذا ما رأت أن أمنها مُهدَّد، وبأن الولايات المتحدة الأميركية والقوى الغربية تجاهلتا مصالح موسكو الأمنية، ويُذكّر النخبة الروسية السياسية والعسكرية على الدوام بأن الانهيار السوفييتي كان أكبر كارثة جيوسياسية عظمى في التاريخ المعاصر، خصوصاً وأن نحو 25 مليون روسي وَجدوا أنفسهم خارج التراب الروسي، ولأنه يرى أوراسيا منصة تفاعلات سياسية وعسكرية واقتصادية بنى بوتين شراكة حقيقية مع الصين، واتفاقات حماية لدول وأنظمة في إيران ومصر والهند وسوريا والجزائر وحتى الخليج، كي تصبح موسكو صاحبة الكلمة الأمنية العليا هناك، وهو ما يمثل حسب خبراء انتصاراً مرحلياً لعقيدة بوتين، بل قفزة في تاريخ الصراع على الجيوبوليتيك بين القوى.
صراع “العقائد الاستراتيجية” بين القوى الكبرى
بين نظريات أمركة العالم والمشروع الأوراسي، لا يمكن اعتبار أن التاريخ يسير في خط مستقيم، فبدايةً، كانت سياسة القبضة الحديدية التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق هاري ترومان مع الاتحاد السوفييتي في خمسينيات القرن العشرين، مستغلاً التفوق الأميركي وتصدر زعامة العالم الرأسمالي ووراثة مستعمرات الإمبراطوريات القديمة، والاجتياح العجيب للعالم بأسره من طرف القوى الصناعية الغربية بعد الانهيار السوفييتي، قد دفعت إلى الاعتقاد بأن توحيد البشرية ثقافياً أمر ممكن وشيك ممكن، وخاصة مع تشكل مركز ديناميكي لابتكارات تقنية فائقة؛ اقتصادية وسياسية وفكرية، وتقابل هذا المركز أطراف جامدة ومهمشة في العالم بحاجة لبناء وتنمية. ولكن ظل التوتر يتصاعد بين روسيا وبجانبها الصين من جهة، ومن جهة أخرى الولايات المتحدة الأميركية وخلفها العالم الغربي، نتيجة الانعطافة الأميركية صوب المحيط الهادي، وهو ما خلق يقظة شرقية وحذراً استراتيجياً، مما دفع القيصر الروسي بوتين وخلال سنوات حكمه إلى إقفال منطقة القوقاز في وجه حلف الناتو وأميركا، وجاء التوسع الروسي في جورجيا وسوريا والقرم ودعم إيران وميليشيا حفتر في ليبيا رداً على حالة التمدد الأميركي، فبوتين بكل تأكيد لن يرضى بالفُتات ليثبّت عقيدته في كل إقليم دخلته جيوشه حسب ما يسميه “دواعي الإنصاف”، وهذا ما عَبَّر عنه وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا في مقابلة له مع “CNN” بالقول: “بوتين يفكر بروسيا وطريقة توسيعها وكيف يقسّم الشرق عن الغرب، يبذل كل ما يستطيع للحصول على النفوذ في الدول السابقة في الاتحاد السوفييتي”.
ولأن التفاعلات في النسق الدولي تتّسم بالفعل ورد الفعل، فظهور وحدات سياسية جديدة، مثل روسيا والصين والهند، يبدو أمراً طبيعياً لإحداث توازن دولي، وهذا الأمر نظَّر له كثير من المفكرين الاستراتيجيين أمثال زبيغينيو بريجنسكي في كتابه “رؤية استراتيجيّة” أنْ لا تتمتع الولايات المتحدة بالنفوذ والزعامة نفسها بعد العام 2025، عارضاً العديد من الأسباب الداخلية والخارجية لهذا التراجع، ومن بينها التدخلات العسكرية في العراق وأفغانستان. ويتّفق المفكّر فريد زكريا في كتابه “عالم ما بعد أميركا” مع طرح بريجنسكي القائل: إنّ أميركا ستبقى على المستوى السياسي والعسكري مهيمنة على العالم، رغم أنَّ البنية الشاملة للأحادية القطبية على المستوى الاقتصادي والثقافي والمالي ستضعف تدريجياً.
هذا التنظير من رواد علم السياسة عززته اعترافات متلفزة من الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، أدلى بها في خطاب له قائلاً: “لا شكَّ في أننا نعيش نهاية الهيمنة الغربية على العالم، والتي امتدّت ثلاثة قرون، فالأمور تتغير، وقد تعمّقت كثيراً بسبب تراكم أخطاء الغرب في بعض الأزمات، وبسبب الاختيارات الأميركية لعدة سنوات، والتي أدت إلى إعادة الصراعات في الشرق الأدنى والأوسط وأماكن أخرى… إنّه أيضاً ظهور قوى جديدة اليوم، لا شكّ أننا قلّلنا من شأنها، وفي مقدمتها الصين، أيضاً الاستراتيجية الروسية، والحقّ يقال إنها تقود منذ بضع سنوات إلى مزيد من النجاح…”. ولكن السؤال الذين يطرح نفسه: كيف يبني الروس سياستهم نحو المجد الأوراسي بالمخ أم بالعضلات؟
تستلهم السياسة الروسية خطواتها وفق ما سُمي حقاً “العقيدة الأوراسية”، والتي ترتكز على قاعدتين أساسيتين:
الأولى: بناء الشراكات والتقارب مع قوى مناوئة أو متوجسة من النفوذ الأميركي.
الثانية: توسيع أراضيها التي تشكل قوساً جغرافياً استراتيجياً، وتضم أراضيَ شاسعة فيها مخزون من أكبر مخازن الثروة الباطنية في العالم.
فالمرتكز الأساسي هو التخطيط واستغلال الفجوات في سياسة القطبية الواحدة ومن ثم استخدام العضلات عند اللزوم، ويقول ألكسندر دوغين في كتابه أسس الجيوبوليتيكا: “قطبان كحد أدنى أو الموت”، هذه هي نتيجة الصراع بين الغربيين والروس، ولقد بلغ الوضع اليوم مستوىً من الواقعية لا سبيل معه إلى لاختيار روسيا بين الحسن والأحسن، فإذا استطاعت أن تقيم استقلالها الجيوبوليتكي، فضلاً عن العودة الواعية للجوار القريب (بدايةً في أوكرانيا) ستكون ضمانة للاستقلال الثقافي والديني واللغوي والاقتصادي والسياسي المستقبلي، وهذه المرحلة الانتقالية المأساوية للغرب حسب دوغين المنطق الأساسي دون شك لزيادة أكبر لعدد الحلفاء والتابعين لروسيا الأوراسية في شرق العالم وغربه.
مهما يكن، فهذا التنظير كله ستثبته تطورات المشهد الأوكراني وما يليه من أحداث، ومدى صمود حلفاء الغرب في كييف تحت ضربات القيصر الروسي في ظل الإمداد الأميركي والأوروبي لهم، فإن كانت النتيجة تحييد أوكرانيا ونزع سلاح جيشها، ودخولها تحت العباءة الإدارية الروسية، فهو ذروة المجد الأوراسي وانتصاراً لعقيدة بوتين الإمبراطورية، وإذا غرق القيصر وجنوده في المستنقع الأوكراني وهذا محتمل، فهي النتيجة التي لن يرضى بها الروس بعد سنوات الإعداد لمثل هذه الخطوة التاريخية الحاسمة، وستكون تسوية تاريخية فاصلة بين الأوراسيين والأطلسيين.
المراجع:
ألكسندر دوغين، أسس الجيوبولتيكا (مستقبل روسيا الجيوبولتيكي)، تعريب: عماد حاتم، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط1 2004.
باتريك جيه. بوكانن، موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وغزوات المهاجرين على الغرب، ترجمة: محمد محمود التوبة، مكتبة العبيكان، السعودية، 2005.
رولان بريتون، جغرافيا الحضارات، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط1 1993.
لافل باييف، القوة العسكرية وسياسة الطاقة: بوتين والبحث عن العظمة الروسية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ط1 2010، ص 147.
تلفزيون سوريا
—————————–
ورطة بوتين القاتلة/ يحيى العريضي
يُقال “عندما يكرر التاريخ نفسه، تكون كلفة التكرار أكثر فداحة”. ما أشبه الأمس باليوم؛ فقُبَيلَ الحرب العالمية الثانية، هادنت بريطانيا العظمى ألمانيا النازية؛ وقبيل غزو صدام حسين للكويت، هادنت أميركا صدام، وقالت سفيرتها “غلاسبي” هناك، إنه إذا تدخل في الكويت، فذلك شأنه، ولن تتدخل أميركا؛ وقبيل غزو بوتين لأوكرانيا، تراوحت مخاطبة بوتين أميركياً وأوروبياً ودولياً بين الترجي والإغراء والتحريض وصولاً إلى تحديد وقت الغزو. وفي خطبته العصماء لاستعادة “الأرثوذكسية” دخل بوتين بالتاريخ، وقدّم أوكرانيا أرضاً وبشراً “وغيرها” كجزء من عالم الاتحاد السوفييتي، وهيبة روسيا الحالية في خطر، وإقليما “لوجانسك، ودوناتسك” يريدان الاستقلال؛ وفي النهاية شنّ حربه، وبدأت مصفحاته تدوس المدنيين وهم بسياراتهم؛ ومع ذلك، فداحة فعل بوتين ورد الفعل لم تظهر كلياً بعد…
في سوريا، وبعد أن استُبْعِد من التحالف المتدخل “لمحاربة الإرهاب”، تدبر بوتين أمره، ودخل تحت يافطة الدعوة من الحكومة السورية “الشرعية”. وها هو لسنوات يحتل سوريا، ويحمي منظومة الاستبداد. وكانت السردية التي يسوقها على الدوام في وجه المطالبين بالتطبيق الحرفي للقرارات الدولية في سوريا: {ممنوع خرق القانون الدولي، وممنوع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو السعي لتغيير النظام بالقوة، أو تهديد وحدة واستقلال وسيادة أي دولة}. وها هو السيد بوتين اليوم يفعل بأوكرانيا تحديداً ما كان ينظّر به، وينهي عنه.
على خطا قادة السوفييت تبدأ الانهيارات والاستهدافات الاقتصادية والعسكرية لروسيا، والتجربة الأفغانية ما تزال ماثلة
قبل فعلته تجاه أوكرانيا، ورغم خطبته “العصماء”، التي تذكّر بخطابات هتلر قبل ثمانين عاماً، كان هناك شبه إجماع عالمي أن الرجل مهزوم إن دخل، وخاسر إن لم يدخل؛ إلا أن عُقَد المغامر تغلّبت عنده، ففعلها معتمداً على فرط القوة الغاشمة، للحصول على القطبية؛ على الأقل عبر التحكم ببلد يطعم 600 مليون شخص، وفي المراتب الأولى عالمياً بإنتاج كل شيء تقريباً. فات الرجل أن ذلك خط أحمر فعلي عالمياً؛ وأن ما ومَن أغراه يريد خنقه في مغطس الجشع والتهوّر. وهذا ما سيكون؛ وبوادره بدأت.
ما فعله بوتين أعاد لحمة أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ ثبّت وشائج العلاقة الأمرو- أوروبية؛ ضرب العلاقة مع الصين، التي تبحث عن مناخ هادئ دولياً لتتألق أكثر اقتصادياً؛ وعلى خطا قادة السوفييت تبدأ الانهيارات والاستهدافات الاقتصادية والعسكرية لروسيا، والتجربة الأفغانية ما تزال ماثلة. زد على كل ذلك الإحساس العالمي بأن عالمنا أمام هتلر بنسخة جديدة.
وبالعودة إلى المغامرة البوتينية في سوريا، حيث أبرزت فعلته الحالية في أوكرانيا تناقضاً بين رفضه لتغيير الأنظمة بالقوة أو تهديد وحدة وسيادة واستقلال بلد ما، كما في الحالة السورية؛ وقيامه بما نهى عنه تماماً في أوكرانيا، لنجد أن تلك التجربة في سوريا، بقدر ما أفادته، ستتحوّل بمغامرته الحالية إلى وبال قاتل:
*بينما القوة العسكرية لنظام الأسد كانت في مواجهة شعب سوريا، (مرفَقَةً بحضر العالم ومنعه عن السوريين ما يمكن أن يدافعوا به عن أنفسهم) إلا أنها في أوكرانيا بمواجهة الغازي، وستهشمه.
*في سوريا راكم بوتين ملفات إجرام عندما جرّب أسلحته الحديثة على أرواح السوريين ومشافيهم ومدارسهم وأسواقهم وتشريدهم وتضييع حقوقهم سياسياً؛ سيجد مَن يرد له الصاع صاعين في أوكرانيا اعتماداً على ترسانة البلد، والدعم الحقيقي الخارجي.
* في أوكرانيا لن يجد بوتين ميليشيات إيرانية تدعمه ميدانياً، ولا مَن يوصّف شعب أوكرانيا بالإرهابي- كما تم التجني على الشعب السوري- ولن تكون النظرة لشعب أوكرانيا غير مبالية، كما كانت تجاه شعب سوريا؛ حيث كان لإسرائيل دور كبير بذلك التشويه.
*في سوريا، كسب بوتين ودَّ إسرائيل بتدمير سوريا وبحمايته لمنظومة استبدادية حرست حدود إسرائيل لزمن؛ ولكن علاقة أوكرانيا بإسرائيل خاصة جداً؛ وسيدفع الثمن الموجع على فعلته، وخاصة من قبلها.
* وضع بوتين يده على موارد سوريا؛ رغم أن أحداً لا يطمع بما تبقى بعد سيطرة أميركا وأداتها “قسد” على أهم ما في سوريا من موارد طاقة وزراعة وماء؛ أما في الحالة الأوكرانية، فهذا البلد في المصافي الأولى عالمياً بموارده وخيراته، حيث يشكّل خزاناً غذائياً لعُشر سكان الأرض، ما يضع الكرة الأرضية بمواجهته.
*وإن كان قد وضع يده على قاعدة حربية في حميميم، فذلك لن يزيد ما لروسيا من مواقع تطول أي نقطة بالعالم بغض النظر عن الجغرافيا؛ ولكن أوكرانيا أهم من تركيا بالنسبة لحلف النيتو وللغرب عامة، وهي مقتل بوتين استراتيجياً؛ ومن هنا، سيجعلها الغرب مقبرة لطموحاته.
*إذا اعتبر بوتين “نظام الأسد” حليفاً شبه وحيد له؛ فأي حليف هذا الذي يفكّر ببيعه في صفقة مع أميركا؛ وهي لا ترضى؟! وأي ملفات إجرامية تشكّل وباءً إضافياً عليه حَمْلُه؟!
*يكفي بوتين أنه تكشّف تماماً كمحتل أمام كل السوريين، وفتح أعينهم على ابتلائهم بالاستبداد والاحتلال أيضاً.
ثورة شعبية سورية جديدة في وجهه ووجه الاستبداد الأسدي ستكون ضرورية ومبررة؛ وستلقى الدعم اللازم عالمياً؛ وعلى الأقل ستلغي تعجرف البوتينية وألاعيبها
* ولا ننسى بالطبع حجم الضرر الذي ألحقه بحليفته إيران على الأرض السورية، وبملفها النووي من خلال فعلته في أوكرانيا، واتضاح شراكتهما الإجرامية؛ ولا يمكن إغفال الضرر والخلخلة لعلاقته مع تركيا؛ والتي ستقف مع العالم ومع حلفائها الأساسيين، لا مع بوتين ومغامراته.
* والأهم من كل ما سبق، فإن ثورة شعبية سورية جديدة في وجهه ووجه الاستبداد الأسدي ستكون ضرورية ومبررة؛ وستلقى الدعم اللازم عالمياً؛ وعلى الأقل ستلغي تعجرف البوتينية وألاعيبها، وسفالة منظومة الاستبداد تجاه عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي يعيد سوريا إلى سكة الحياة.
ها هو التاريخ الهتلري القديم يعيد نفسه؛ ولكن الثمن أعلى مما يتصوره بوتين. والتاريخ الحديث لفعلته في سوريا يعيد نفسه؛ ولكن بدهاء، وأكثر سخرية، وسيكون أكثر وبالاً ومأساوية؛ وستكون أفغانستان نزهة مقارنةً بالقادم.
———————————

روسيا وأوكرانيا… البحث عن حوار في كومة قش! / هادي جان بوشعيا
عقب توقيع اتفاق “مينسك 2” في شباط (فبراير) 2015، من اليمين (مع صفات القادة حينها) الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
بين أوكرانيا وروسيا نار مشتعلة وحوار منتظر، وضمنهما تاريخ يعجّ بالأشياء المشتركة، فضلاً عن اتفاقات طواها الماضي وخلافات فرضها الحاضر، ومستقبل يبحث عن هويته.
بينما تستمر المعارك بلا هوادة، يقول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إن بلاده مستعدة لتوفير منصة تفاوض بين روسيا وأوكرانيا في مينسك. وهذه دعوة قبلتها كييف، ثم عاد رئيسها أمس ليقول إنه يريد السلام.
قبلت روسيا، من جهتها، هذه الدعوة، وتقول إنها مستعدة لإرسال وفود من وزارتي الدفاع والخارجية إلى مينسك بهدف التفاوض، ولكن الكرملين يقول إن أوكرانيا لا تريد التفاوض، وهي بذلك رفضت هدنة قد توقف حمام الدماء بين الجانبين.
ومع أن فرصة الحوار ضئيلة، وفق طرفي النزاع، كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، لكنها تبقى قائمة. ذلك أن لكل طرف شروطه، لكنّ للمكاسب الميدانية والشروط المسبقة والتحالفات قولاً سيكون فيصلاً في أزمة تراها بريطانيا ذات عمر طويل ودماء كثيرة.
مسارٌ ممزّق
تاريخياً، عاشت أوكرانيا مساراً ممزّقاً بين الانحياز للغرب ومعادلة الجغرافيا والتاريخ للدولة الروسية. فبعد تفكك الإمبراطورية الروسية قبل نحو قرن من الزمن، شهدت البلاد فترة قصيرة من الاستقلال امتدت لخمس سنوات، قبل أن يفتك بها الاتحاد السوفياتي بالقوة تحديداً عام 1922، لتصبح حجر زاوية في هذا الاتحاد، وثاني أكثر الجمهوريات السوفياتية سكاناً بعد روسيا.
علاقة متينة… فإعلان الانفصال
وعاشت أوكرانيا في كنف الاتحاد السوفياتي، ووصلت علاقتهما الى مرحلة قوية، حتى أن الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف منح أوكرانيا شبه جزيرة القرم عام 1954، بغية تقوية الأواصر الأخوية بين الشعبين كما كان يوصف.
في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1991، وقّعت كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا اتفاقية أدت فعلاً إلى حلّ الاتحاد السوفياتي. إذ اعتقدت موسكو حينها أن كييف ستبقى تحت ظلّها بالاعتماد على إغراءات الغاز الرخيص؛ إلا أن أوكرانيا بدأت تميل شيئاً فشيئاً نحو الغرب.
“صيغة نورماندي”… واتفاقيّة مينسك
بحلول عام 1997، وقّعت موسكو وكييف معاهدة “الصداقة والتعاون والشراكة” التي تعترف روسيا على إثرها بحدود أوكرانيا الرسمية، بما يشمل شبه جزيرة القرم.
لكن في حزيران (يونيو) من عام 2014، التقى الرئيس الأوكراني المنتخب حديثاً وقتذاك بيترو بوروشنكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعُرف الاجتماع في ما بعد باسم “صيغة محادثات نورماندي”، وذلك بوساطة ألمانية وفرنسية.
وساطة أوروبيّة
الوحدات الأوكرانية تعرّضت لهزيمة كبيرة على يد الانفصاليين، لكن في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2014، توصل الأطراف الى توقيع اتفاق وقف النار في مينسك. ثم تدخّل الغرب في ما بعد لتطبيق ما عُرف بـ”بروتوكول مينسك”، إذ شهدت باريس “قمة نورماندي” باتفاق رؤساء دول وحكومات روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في كانون الأول من عام 2019 التي وافق فيها المشاركون على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات العسكرية من خطوط المواجهة.
عام 2022، عاد الحديث عن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، حينما أصرّت روسيا على شن عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، وعلى إثرها طالبت كييف دولاً عدة، منها إسرائيل، بالتوسط لدى الكرملين لبدء عملية تفاوضية تنهي الأزمة.
بين الاقتصاد والسّياسة
على الرغم من ذلك كلّه، تسود بين كييف وموسكو جملة من الخلافات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الحالية، عزّزتها الحرب الأخيرة، ودفعت بالكثير منها إلى الواجهة، منها مطالب روسية وأوكرانية نستعرضها على النحو الآتي:
– رفض روسيا تسليح كييف وتريدها منزوعة السلاح.
– أوكرانيا تطالب الغرب بتزويدها بمزيد من الأسلحة.
– تعتبر روسيا انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” تهديداً مباشراً لها.
– رغبة أوكرانية جامحة بالانضمام إلى الحلف، منتقدةً بطء العملية.
– تريد روسيا أن تكون أوكرانيا ضمن مناطق نفوذها.
– مساعٍ أوكرانية للالتحاق بالتكتل الأوروبي منذ فترة طويلة.
– تقول موسكو إن منطقة القرم خضعت لاستفتاء قضى بضمها إلى روسيا.
– تعتبر أوكرانيا القرم منطقة محتلة وتريد استرجاعها.
– تتهم روسيا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بالتبعية والانقياد للغرب.
– يقول زيلينسكي إنه مستهدف من موسكو.
– تريد روسيا اجتثاث النازية من أوكرانيا.
– تقول أوكرانيا إن نظامها ديموقراطي وجاء بطريقة شرعية.
في المحصلة، تُعقد حالياً أهم المحادثات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهذا سبب آخر يجعل من المهم إحراز تقدم في صيغة نورماندي، رغم صعوبة ذلك.
ولكن يبقى السؤال الأوسع: كيف تكون مسارات المفاوضات بحسب صيغة نورماندي؟ خصوصاً إذا ما كان بوتين جاداً بشأن مطالبه الكبيرة، والتي يجد الغرب على ضفتي الأطلسي استحالة قبولها، بما في ذلك مناطق نفوذ مضمونة في أوروبا، فلن يكون هناك تقدم؛ إلا أن الاعتقاد السائد يشي بأن المساهمة في تخفيف الوضع العام ممكنة.
النهار العربي
————————-
أي تداعيات للأزمة الأوكرانية على العملية السياسية في سورية؟/ أمين العاصي
تشير جميع المعطيات إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكون لها العديد من التداعيات السلبية على العملية السياسية في سورية، وهو ما حذّرت منه منظمة الأمم المتحدة، التي نجحت أخيراً في تحديد موعد لجولة سابعة من اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” بعد توقف دام أشهراً.
وأبدى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، خشيته من انعكاس الصراع الدائر في أوكرانيا على العملية السياسية في سورية، مشيراً في إحاطة له لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة إلى أن الدبلوماسية الدولية البنّاءة المطلوبة لدفع العملية السياسية في سورية “قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا”.
وكان بيدرسن قد جال أخيراً على عدد من العواصم المعنية بالأزمة السورية، فضلاً عن زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، في محاولة لإحياء العملية السياسية المرتبطة بسورية، خصوصاً لجهة مسار التفاوض حول سلّة الدستور، المتوقف منذ أواخر العام الماضي.
وأثمرت جهود بيدرسن عن تحديد موعد الجولة السابعة للهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين من المعارضة والنظام، والمجتمع المدني من كلا الطرفين، في 21 مارس/آذار المقبل في مدينة جنيف السويسرية.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام حول كتابة دستور جديد للبلاد، انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلا نتائج، في دلالة واضحة على عبثية التفاوض حول الدستور في ظل تعنّت النظام ورفضه التعامل الجاد مع جهود الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد حدّدت في عام 2017 سلالاً للتفاوض بين النظام والمعارضة، هي: الحكم، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب. وأعلن عن هذه السلال المبعوث الأممي السابق إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في ذلك الوقت، وفقاً للقرار الأممي 2254 لعام 2015 والذي رسم حلاً سياسياً شاملاً للقضية السورية.
وتأمل الأمم المتحدة أن تشكّل كتابة دستور جديد لسورية مدخلاً واسعاً لحل القضية السورية برمتها، على الرغم من أن القرار الدولي 2254 كان قد دعا إلى تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات من النظام والمعارضة، تشرف على كتابة دستور تجري على أساسه انتخابات.
واضطرت المعارضة السورية تحت ضغوط إقليمية للقبول بالتفاوض على سلّة الدستور أولاً قبل تحقيق انتقال سياسي جدي، ما يعني نسف التراتبية في القرار الدولي 2254 المستند إلى بيان جنيف 1 الصادر في منتصف عام 2012.
أما النظام فبقي، بدعم روسي، على موقفه الرافض لكتابة دستور جديد، بل القيام بـ”إصلاح” على دستور وضعه في عام 2012 جرت على أساسه انتخابات رئاسية مرتين، الأولى في عام 2014 والثانية في عام 2021 وفاز بهما بشار الأسد، الذي يعطيه دستور 2012 صلاحيات واسعة النطاق، تمكنه من التحكم بالبلاد بشكل مطلق.
ولا يكترث النظام بالعملية السياسية، فهو يطلق على المعارضة السورية صفة “الإرهاب”، ويسوّق اتهامات بـ”العمالة” بحق المعارضين السوريين من مختلف التيارات والمشارب السياسية.
النظام السوري… استغلال إضافي لأزمة أوكرانيا
ومن المتوقع أن يواصل النظام السوري تعنّته، على الرغم من قبوله إرسال وفده إلى جنيف الشهر المقبل، مستفيداً من الأوضاع الساخنة في أوكرانيا واتساع نطاق الضغط الدولي على الجانب الروسي، الحليف الأساسي لهذا النظام الذي يحاول استغلال الأوضاع السياسية المستجدة لصالحه.
وسارع النظام إلى إعلان تأييده التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل مقداد، منذ يومين، إن التنسيق السوري الروسي لم يعد في إطار التخمينات، وهو تنسيق استراتيجي ومستمر وعميق، وستظهر آثاره على مختلف المستويات.
من جهته، دان الائتلاف الوطني السوري المعارض، والذي يمثل المعارضة السورية، التدخّل الروسي في أوكرانيا، مبدياً “خشية حقيقة من نوايا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تجاه سورية ووحدة أراضيها، لا سيما مع عقود الإذعان التي يقدّمها النظام المجرم لروسيا، وما يقوم به من رهن مقدرات البلاد وثرواتها وساحلها وأراضيها لقوات الاحتلال الروسي”، وفق بيان.
ومن الواضح أن النظام يأمل ألا يمارس الروس عليه ضغوطاً لتقديم تنازلات في العملية السياسية في ظل التشنج بين موسكو والغرب، والذي وصل إلى أقصى حدوده.
لكن المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي، طه عبد الواحد، رجّح في حديث مع “العربي الجديد”، أن تدفع موسكو باتجاه أي حل سياسي في سورية “يُبقي بشار الأسد في السلطة، أو على أقل تقدير يضمن لها ظهور نظام حكم يمنحها الامتيازات ذاتها التي حصلت عليها من الأسد”.
ومنذ بدء المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة بين النظام والمعارضة، لم يضغط الجانب الروسي على النظام السوري بشكل يدفعه إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة. بل استغلت موسكو حاجة النظام إليها للحصول على مكاسب جمّة في سورية، أبرزها القاعدة العسكرية في منطقة حميميم على الساحل السوري، والتي يستعرض فيها الروس قدراتهم العسكرية في خضم الأزمة الأوكرانية.
واعتمد النظام على موسكو في تصلب موقفه تجاه مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في سورية، مستغلاً تردد الغرب بقيادة الولايات المتحدة في الملف السوري، وترك حرية التحكم لموسكو بمفاصل القرار في سورية.
روسيا في سورية بعد الحرب: مرونة أم تشدد؟
وفي هذا الصدد، رأى الباحث والمحلل السياسي رضوان زيادة، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الموقف الروسي في سورية لجهتي التشدد أو المرونة “يعتمد على ردة الفعل الغربية الأوروبية والأميركية إزاء ما يحدث الآن في أوكرانيا”. واعتبر أنه “إذا كان الرد الغربي على الجانب الروسي قوياً، وكانت هناك مقاومة كبيرة من الشعب الأوكراني، فهذا كفيل بإضعاف روسيا”.
وأعرب الباحث عن اعتقاده بأن “روسيا ضعيفة في أوكرانيا، يعني أنها ضعيفة أيضاً في سورية، وهو ما سيجبرها على التخلي عن قواعدها العسكرية في سورية، ودعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري لنظام بشار الأسد”.
في السياق، رأى الباحث في مركز “الحوار السوري” أحمد القربي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الموقف الروسي حيال ما يجري في سورية “متأثر بالموقف التركي (من أوكرانيا) كون المعارضة السورية محسوبة على أنقرة”.
وأضاف أنه “لا توجد عملية سياسية في سورية، ومن ثم التشدد الروسي سيكون في الميدان أكثر”. واعتبر أنه “إذا كان هناك تدخل تركي مؤيد لأوكرانيا، فمن الممكن أن تشهد سورية تصعيداً عسكرياً روسياً ضد مناطق المعارضة السورية في الشمال”.
العربي الجديد
——————————
النظامُ السوري: العميلُ الروسي بالوكالة/ عبير نصر
كثيراً ما يخلص محللون إلى أنّ السمةَ الأخطر في عقلية النظام السوري هو تماهيه مع آلياتٍ عديدة استعملها من أجل جعل التغيير والمطالبة به من أكبر المحرمات. وهذا يعطينا درساً لا يُنسى في مدى توحشه ودمويته، في وقتٍ تشير فيه أرقام رصدتها لجان حقوق إنسان إقليمية ودولية إلى أنّ نظام الأسد يعتبر من بين أكثر الأنظمة في المنطقة العربية ظلماً وعدواناً على شعبه، والمجازر التي ارتكبها في الحولة وكرم الزيتون وجورة الشياح وخان شيخون ودرعا وريف دمشق.. تعكس بوضوح جليّ سلوكه الحقيقي، وتؤكد شعاره الشهير “الأسد أو نحرق البلد”.
هذه السمة تقودنا ببساطة إلى فهم طبيعة اليأس الذي يسيطر اليوم على المشهد السوري، فرغم كل الاحتقان الاجتماعي والمعاناة اليومية لملايين السوريين، فإنّ الخوف من الأسوأ صار يشكل حاجزاً سميكاً أمام كلّ مبادرة للحركة والفعل، بينما أثبتت التجربة أنّ أيّ فرصة للتغيير تتحول حكماً إلى حمام من الدم والأشلاء. وحقيقة خطابُ شيطنة التغيير وجد صداه في مستويات أبعد من هذا بكثير، فهو لا يقتصر على منع سقوط نظام الأسد، بل يهدف أيضاً إلى جعل الواقع المرير قدراً لا خلاص منه، بينما لا يستمد هذا النظام شرعية وجوده من الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقدر ما يستمدها من قدرته على كسر عزيمة المطالبين بواقع أفضل. وعليه من الطبيعي أن يستنجد بالقوة الإقليمية التي لا تقلّ عنه عنفاً وتوحشاً. نتحدث عن روسيا بالطبع، التي استفاقت فجأة على تغوّل الإمبراطوريات المنافسة، وعلى رأسها الإمبراطورية الأمريكية، المستفيدة من سقوط الاتحاد السوفياتي ومن دخول روسيا مرحلة انكماش تاريخي خلال العقد الماضي. وطبيعي أيضاً أن تغدو الثورة السورية منعرجاً حاسماً في تاريخ الصراع مع الاستبداد، وما إن تمّ إجبارها على التسلح حتى تأكدت بشاعة النظام السوري، وأنه قادر على الذهاب إلى أبعد حدود التوحش من أجل الحفاظ على كرسيه.
بطبيعة الحال، دخلت روسيا الساحة السورية بعدما أدركت أنّ النظامَ السوري، أو بتعبير أدقّ وكيلها الاستعماري، ساقطٌ لا محالة، مستعملة كلّ الأسلحة المحرمة دولياً من أجل إرهاب الشعب وإطالة عمر الحليف المتهالك. ولا يخفى على أحد أنه لم يكن التدخل العسكري الروسي يهدف لإنقاذ الأسد من السقوط، حرفياً، بقدر الإبقاء على المصالح الروسية بما فيها صفقات التسليح ومجموع القواعد العسكرية الروسية، إضافة إلى الممرات البحرية والبرية التي تشكلها سوريا لصالح القوة الروسية. وتاريخ الجيش الروسي شاهد على ذلك، بعدما دخل في حروب ومواجهات عسكرية شملت عدّة بلدان منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فمن الشيشان التي خاضت روسيا فيها حربين دمويتين في 1994 و1999 أدت لمقتل عشرات الآلاف، مروراً بجورجيا في 2008، وصولاً إلى سوريا عام 2015، ولن يكون آخرها بالطبع الحرب على أوكرانيا. وفعلياً أدى التدخل الروسي في سوريا، الذي ترافق مع عمليات قصف دامية ودمار هائل، إلى تغيير مسار الحرب ما سمح للنظام السوري بتحقيق انتصارات حاسمة، واستعادة المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المقاتلة المعارضة. في المقابل المعطيات كلها تشير إلى أنّ بشار الأسد لا يمكن أن يكون رمضان قاديروف جديداً، والحديث هنا عن الرئيس الشيشاني، الذي يحكم بلاده كمندوب سامٍ روسي، لا يختلف عن المندوب الفرنسي أو الإنكليزي خلال فترة الاستعمار. ويبدو أن الأسد لن يحصل على هذه الترقية -المنصب- في سوريا، فهو ليس إلاّ وكيلاً ضعيفاً تابعاً، بعدما تحولت مناطق سيطرته إلى ساحاتٍ مفتوحة لصولات وجولات القوات الروسية. بدلالة أنه في كانون الثاني/ يناير المنصرم، أقلعت ثلاث طائرات روسية من قاعدة حميميم، واثنتان سوريتان من مطارين عسكريين بريف محافظة دمشق السورية، وفي خطوة هي الأولى من نوعها أجريت “دورية جوية مشتركة” على طول مرتفعات الجولان، وأجواء المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا.
وسرعان ما أثار ذلك العديد من التساؤلات، فيما انعكس الأمر على وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها، والتي أفردت بدورها مساحة إخبارية، استعرضت من خلالها عدة قراءات لأهداف هذه الدورية، والدلالات المرتبطة بها، معتبرة أنها “تحمل رسالة”. وحكماً هذه المناورات التي تجريها موسكو في الأجواء السورية ليست من باب الصدفة، بينما يتم تكثيفها الآن لاستعراض العضلات الروسية أمام الغرب. في سياق متصل لم يكن غريباً أن يسارع وزير خارجية النظام السوري إلى الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، لوهانسك ودونيتسك، بعد ساعات من اعتراف بوتين بهما كدولتين مستقلتين. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، قال المقداد “إنّ دمشق (ستتعاون) مع المنطقتين في شرق أوكرانيا.” جدير ذكره أيضاً أن النظام السوري اعترف سابقاً بالمنطقتين الانفصاليتين، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بعد الحرب الروسية الجورجية عام 2008.
والحقيقة تُقال إن سيطرة روسيا على الأرض السورية، تعني فرض أمر واقع، ولهذا ذهبت لصناعة ما يسمى الدستور السوري، وصنعت عدّة مؤتمرات تخالف ما اتفق عليه في مؤتمر جنيف (1) ومخرجاته التي أصبحت المرجعية في حلّ القضية السورية. وما مؤتمر اللاجئين إلاّ جزء من إعادة تأهيل النظام وصك براءة له من كلّ جرائمه. وعودة اللاجئين تعني إعادة إعمار تتكفل به الدول الثرية، كذلك القفز على قضية المعتقلين، ومن صُفّي منهم وهم عشرات الآلاف، كما بينت تسريبات قيصر، وكلها جرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
بهذا المعنى وفَّرت الأزمة السورية فرصة لتوكيد دور روسيا على المستوى الدولي، في مواجهة تجاهل واستخفاف غربيين، ورداً على ما تراه موسكو حصاراً غربياً استراتيجياً واقتصادياً. وحتى من الناحية الاستراتيجية المجردة، وبغضّ النظر عن العلاقات الروسية – الغربية المتوترة، تحتفظ موسكو بقاعدة بحرية عسكرية في طرطوس، هي القاعدة الوحيدة للروس في حوض المتوسط، ومركز تنصت تجسسي رئيسي في جبال اللاذقية، هو الوحيد في الشرق الأوسط.
نافل القول إنه لا شك مثَّل التدخل الروسي المباشر في سوريا نجاحاً تكتيكيّاً، لكنه في نفس الوقت يواجه عقبات كبيرة، تحول دون تحويله إلى نجاحٍ استراتيجي، بل قد تجعله حرب استنزاف تقضي على النتيجة السياسية المتوخاة، في وقتٍ لم يكن هدف النظام السوري من التحالف مع روسيا إلا البحث عن آلياتٍ مبتكرة لتشويه النماذج الثورية، سواء بشيطنتها ووسمها بالخيانة، أو عبر تسليحها من الداخل ليبرر قمعها والقضاء عليها، رافضاً أيّ إصلاح جدي، لكي يُفتح الباب على كلّ أشكال الفوضى الممكنة. على هذا سيكون من المستحيل حتماً حصر الطريق إلى الموت في سوريا، لكنّنا بلغنا في هذا المضمار ما لم تبلغه الأمم الأخرى، في مؤشر خطير على تآكل الأمة من الداخل.
مع هذا ومهما بالغ النظام السوري في الهروب إلى الأمام، وفي منع كلّ شروط التغيير السلمي، فإن حركة التاريخ سيكون لها رأي آخر تماماً. إذ لا يمكن لأيّ نظام قمعي مهما بلغ من التوحش والعنف أن يمنع شروط التغيير الاجتماعي، ما لم يصنع هو نفسه الشروط الحقيقية التي تضمن له البقاء، حيث لم تصمد في التاريخ الحديث والقديم أعتى الأنظمة المستبدة، لأنها بكلّ بساطة لا تمتلك شروط البقاء.
ليفانت – عبير نصر
——————————

تقليم “أظافر” أوكرانيا و”مخالب” الناتو.. عملية عسكرية وليست حرباً/ رامي الشاعر
خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، أعلن مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا سوف تنجز مهامها في أوكرانيا قريباً، ونفى قصف الجيش الروسي لمدن أوكرانية.
وكانت روسيا قد صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظراً لـ “طابعه المعادي لروسيا”، حيث علّق نيبينزيا بأن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء “القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا” عام 2014، والجرائم التي ارتكبوها والدعم الغربي لها. مضيفاً أن الغرب جعل من أوكرانيا “بيدقاً في لعبته الجيوسياسية”.
لقد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه المطول والمفصّل حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في 21 فبراير الجاري، على طبيعة العلاقة الحميمة بين الشعبين الروسي والأوكراني، فأوكرانيا ليست مجرد دولة مجاورة، وإنما هي “جزء لا يتجزّأ من تاريخنا وثقافتنا وعالمنا الروحي” وفقاً لبوتين. وتابع: “هؤلاء هم رفاقنا وأقاربنا، ومن بينهم ليس فقط الزملاء والأصدقاء ولكن أيضاً الأقارب، ومن تصلنا بهم صلات الرحم والقربى”.
لطالما حذّرت روسيا على مدار ثماني سنوات طويلة مجحفة، عانى فيها سكان إقليم الدونباس ويلات الحرب والدمار والشعور المستمر بالخطر الداهم الذي ينتظر على قارعة الطريق. فالعصابات الأوكرانية المتطرفة، وفي أحيان كثيرة بدعم من الجيش الأوكراني النظامي، لم تكن تفرق بين أهداف عسكرية وأخرى مدنية، ووقع في تلك السنوات عشرات ومئات القتلى من الأطفال والنساء، وقصفت المشافي والمدارس وحضانات الأطفال.
وطوال تلك المدة، حاولت روسيا جاهدة أن ترأب الصدع بين مكونات المجتمع الأوكراني، التي شرخها انقلاب عام 2014، فانشق عن البلاد الجزء الشرقي والجنوبي، ممثلاً جبهة صلبة لمعارضة النظام في كييف، فلم يكن من كييف إلا أن لجأت لحلول عسكرية عنيفة، أثبتت فشلها، ثم لجأت العصابات المتطرفة إلى الاغتيالات والأعمال الإرهابية، ولجأت الحكومة إلى سياسة الحصار والتجويع وقطع المعونات الإنسانية عن مواطنيها في الشرق والجنوب، لتصبح تلك المنطقة المتاخمة للحدود الروسية “عضواً منبوذاً” في الجسد الأوكراني، تحاول كييف ضمه بالقوة، بينما لسان حالها يدفع نحو بتره.
وعلى مدار السنوات الثمانية، وبكل الطرق المشروعة، استمرت توسلات تلك المنطقة لاعتراف روسيا باستقلال هذه الجمهوريات، إلا أن روسيا أصرّت على موقفها الذي يحترم القانون الدولي، ويلتزم بعلاقات حسن الجوار مع الشقيقة أوكرانيا، فكانت النتيجة اتفاقيات مينسك، التي حاولت روسيا وفرنسا وألمانيا من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن توقف حمام الدم بين الأخوة، وأن تدفع كييف نحو الالتزام بتلك الاتفاقيات التي تحفظ حق جميع الأطراف، وتؤمن لأوكرانيا وحدتها وسيادتها على أراضيها. لكن أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تصرّ على خرق الاتفاقيات، وعلى تفضيلاتها لأن تكون مثلما جاء في تصريحات مندوب روسيا في الأمم المتحدة “بيدقاً في لعبة الغرب الجيوسياسية”.
لكن الأمر، مع شديد الأسف، لم يتوقف عند هذا الحد، وبدأت مخالب أوكرانيا تنمو رويداً رويداً، حتى جاء خطاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير، ولتضع أوكرانيا كل شيء على الطاولة، وتطالب حلف “الناتو” بالانضمام في أسرع وقت ممكن، وتلوّح بالخروج من مذكرة بودابست، واستعادة “الوضع النووي” لكييف، وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس الروسي في خطابه بقوله إن ذلك ليس مجرد “تبجح فارغ”، وإنما هو تهديد حقيقي، لأن أوكرانيا بالفعل تمتلك تقنيات نووية سوفيتية، ووسائل لإيصال مثل هذه الأسلحة، بما في ذلك الطيران، وكذلك صواريخ “توتشكا-يو” العملياتية والتكتيكية، ذات التصميم السوفيتي، والتي يبلغ مداها أكثر من 100 كيلومتر، وتلك مسألة وقت لا أكثر.
وتابع بوتين في خطابه: “سيكون من الأسهل على أوكرانيا امتلاك أسلحة نووية تكتيكية، لا سيما في حالة الدعم التكنولوجي من الخارج، ويجب ألا نستبعد ذلك أيضاً. إن الوضع في العالم، وفي أوروبا، وخاصة بالنسبة لنا في روسيا، سوف يتغيّر بالطريقة الأكثر جذرية، مع ظهور أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا. فلا يمكننا الفشل في الرد على هذا الخطر الحقيقي، خاصة وأكرر، أن الرعاة الغربيين يمكن أن يساهموا في ظهور مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا من أجل خلق تهديد آخر لبلادنا”.
إن الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا في السنوات والأشهر الأخيرة جعلت من أوكرانيا برميل بارود قابل للتفجير في أي لحظة، والذي ستكون روسيا وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية الوجودية أول المتضررين منه. وقد رأينا بكل وضوح كيف يحاول الغرب على أرض الواقع، وبكل صلف وغرور وعنجهية، أن يضرّ بالمصالح الروسية في أماكن مختلفة من المحيط الروسي خلال الأعوام السابقة، حتى أصبح ذلك التهديد يطوّق عنق روسيا ممثلاً في أوكرانيا.
لقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية و”الناتو” في التعرف على مسرح العمليات العسكرية المحتملة في أوكرانيا دون أن يثير ذلك حفيظة أحد، ودون أن يضع الغرب في اعتباره المصالح الأمنية الروسية بالمرة، وكان التركيز الواضح في التدريبات المنتظمة المشتركة مع أوكرانيا هو العداء لروسيا، في ظل حملة شعواء، تقودها تنظيمات يمينية متطرفة، تختلف في درجات تطرفها، وصولاً إلى الإرهاب الصريح.
وفي السنوات الأخيرة، وفقاً لبوتين، وبحجة التدريبات، كانت الوحدات العسكرية لدول “الناتو” موجودة تقريباً وبشكل دائم على أراضي أوكرانيا. بل وتم دمج نظام القيادة والتحكم للقوات الأوكرانية بالفعل مع أنظمة “الناتو”، وهو ما يعني أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وحتى الوحدات الفردية والفرعية، أصبح من الممكن القيام بها مباشرة من مقر “الناتو”.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت شبكة المطارات التي تم تحديثها بمساعدة الأمريكيين في “بورسيبول” و”إيفانو-فرانكوفسك” و”تشوغويف” و”أوديسا” وغيرها قادرة على ضمان نقل الوحدات العسكرية في أقصر وقت ممكن، بينما أصبح المجال الجوي لأوكرانيا مفتوحاً لرحلات الطائرات الاستراتيجية والاستطلاعية الأمريكية، وغيرها من المركبات الجوية غير المأهولة التي تستخدم لمراقبة الأراضي الروسية.
كذلك صرّح الرئيس الروسي بأن مركز العمليات البحرية في أوتشاكوفو، والذي بناه الأمريكيون، يجعل من الممكن ضمان تحركات سفن “الناتو”، بما في ذلك استخدامهم لأسلحة عالية الدقة ضد أسطول البحر الأسود الروسي، وبنية روسيا التحتية على طول ساحل البحر الأسود بالكامل.
وفي ظل وثائق التخطيط الاستراتيجي الأمريكية، ووجود بند ما يسمى بـ “الضربة الاستباقية” ضد أنظمة صواريخ العدو، الذي تنص عليه الوثائق الأمريكية الرسمية ووثائق “الناتو” بصفته التهديد الرئيسي لأمن أوروبا والمحيط الأطلسي، وفي ظل تمدد “الناتو” شرقاً عبر خمس موجات: في العام 1999، تم قبول بولندا وجمهورية التشيك والمجر في التحالف، في العام 2004، بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، في العام 2017 الجبل الأسود، وفي العام 2020 مقدونيا الشمالية. وفي ظل نشر مناطق مواقع للصواريخ المضادة كجزء من المشروع الأمريكي لإنشاء نظام دفاع صاروخي متوافق ومعمم في رومانيا وبولندا، بحيث تكون منصات الإطلاق موجودة، وصالحة لاستخدامها لصوايخ توماهوك، الأنظمة الهجومية الضاربة، وليست “الدفاعية” المتسقة مع “سياسة حلف الناتو الدفاعية”. وفي ظل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير الصاروخ المدمج “ستاندارد-6″، القادر على إصابة الأهداف الأرضية والسطحية، علاوة على حل مشكلات الدفاع الجوي والمضاد للصواريخ، وهو ما يشي بتوسع نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي بقدرات هجومية جديدة. وفي ظل المعلومات المتاحة، والتي تجعل كل الأسباب المنطقية لجعل دخول أوكرانيا إلى “الناتو”، والنشر اللاحق لمنشآته هناك هو أمر مفروغ منه، ومسألة وقت.
في ظل هذا كله، لا أعتقد أن أي دولة في العالم يمكن أن تقبل مثل هذه المخاطر على حدودها، خاصة في ظل نظام غير مستقر، تسيطر عليه عصابات متطرفة، تمارس القتل والاغتيال وملاحقة المعارضين وإغلاق القنوات التلفزيونية، وحجب حق بعض شعوبها عن ممارسة حياتهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بأصولهم العرقية والقومية، حتى يصل الأمر بقوانين البلاد، في ظل اختطافها من قبل هذا النظام، أن تصنّف مواطنيها إلى سكان “أصليين” و”غير أصليين”!
في ظل هذا كله، لا أعتقد أن ما تقوم به روسيا الآن، سوى عملية عسكرية لـ “تقليم أظافر” الشقيق، الأوكراني، التي من الممكن أن تتحول إلى “مخالب” مؤذية لحلف “الناتو” تنهش في جسد الدب الروسي، الذي جاهد طويلاً لالتزام الهدوء والصبر والحكمة ورباطة الجأش، وبذل مجهودات خارقة كي لا يتدخل في الشأن الأوكراني، وبحث عن كل المخارج الممكن لتجنب المواجهة مع “الناتو”، إلا أن الأمر قد خرج عن حدوده، وأصبح يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي الروسي، ومصالح البلاد الاستراتيجية، وأصبح يهدد وجود الدولة الروسية والشعب الروسي.
أتمنى بكل صدق وأمل أن تنتهي العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن نطوي صفحة الأزمة الأوكرانية، وأن تهدأ الأمور وتعود إلى مجاريها بين الأشقاء. فتلك حضارة واحدة وتاريخ واحد ومستقبل واحد نأمل أن ننعم به جميعاً.
ليفانت – رامي الشاعر
—————————
ماذا بعد؟/ معقل زهور عدي
تحتاج أوكرانيا لمعجزة لتتمكن من الصمود طويلا في وجه آلة عسكرية جبارة كالآلة العسكرية الروسية , لكن ما أظهره الشعب الأوكراني من مقاومة حتى الآن يكفي لتقدير المصاعب الكبيرة التي تنتظر روسيا في تحويل الحملة العسكرية إلى وقائع سياسية مستقرة . هكذا ستتحول الخسائر الكبيرة التي ألحقها الأوكرانيون بالجيش الروسي , والخسائر الكبيرة أيضا التي ألحقها الجيش الروسي بالبنية التحتية لأوكرانيا وبالضحايا من المدنيين والعسكريين وتحويل مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى لاجئين مشردين بعيدا عن ديارهم , كل ذلك سيتحول إلى وقود لحرب طويلة الأمد لن تخمد نارها قبل خروج آخر جندي روسي من أوكرانيا والانتهاء من كل آثار ونتائج الاحتلال . كيف سينظر الأوكرانيون بعد اليوم إلى حكومة يقوم بتنصيبها الكرملين فوق آلاف الجثث والدمار وتحت المدافع الروسية سوى أنها حكومة احتلال كما كانت حكومة فيشي في فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية والتي نظر إليها الفرنسيون كدمية بيد ألمانيا النازية ؟ وكيف ستستطيع روسيا المعزولة عالميا والتي سيتعرض اقتصادها إلى عقوبات قاسية من تحمل أعباء الإحتلال والوقوف بوجه شعب بتعداد يقارب 44 مليون نسمة تقترب مساحته من مساحة فرنسا يقع في قلب أوربة ويتصل مع بولندا ورومانيا الأعضاء في حلف الناتو ؟ لقد أيقظت الحملة العسكرية الروسية الغرب خاصة الشعوب الأوربية من حلمهم أن الحرب العالمية الثانية هي آخر الحروب , واستفزت في ذاكرتهم كل المخاوف والآلام التي عاشتها أوربة والعالم بسبب تلك الحرب . شعر الناس هناك وكأن ساعة الزمن عادت بهم فجأة ثمانين عاما إلى الوراء , وأن أوربة مهددة اليوم بحرب عالمية قد لاتخلف وراءها سوى المقابر والرماد . من الطبيعي أن تتحول تلك الصدمة والمخاوف التي أطلقتها الحملة العسكرية الروسية إلى مشاعر قوية تدفع نحو محاصرة مصدر النيران قبل أن تتسع إلى حريق . وليس ثمة عاقل يمكن أن يناقش فيما إذا كان لروسيا الحق في اجتياح أوكرانيا وتدمير جميع مقدراتها العسكرية ” تجريدها من السلاح حسب الاعلان الصريح لبوتين ” لمجرد كونها جارة لروسيا الامبراطورية ! ليس هناك شك في أن بوتين كان يراهن على حملة عسكرية خاطفة تدفع الجيش الأوكراني للاستسلام سريعا بطريقة مشابهة لحرب الولايات المتحدة على العراق عام 2003 , فإذا كان يحق للولايات المتحدة غزو بلد يبعد عنها آلاف الكيلومترات لأسباب اتضح أنها كاذبة تماما وتدمير الجيش العراقي وتنصيب حكومة تتفق مع مصالح الولايات المتحدة فلماذا لايحق لروسيا غزو جارتها التي تمردت على تاريخ طويل من الهيمنة الروسية وتوجهت للغرب مهددة بإحضار الناتو إلى حديقة القلعة الروسية ؟ مشكلة تفكير كهذا أنه تجاهل حقيقتين , الحقيقة الأولى أن مشروع احتلال العراق أثيت فشله بعد الخسائر التي منيت بها الولايات المتحدة في العراق والتي لم تكن تتوقعها , وأيضا بعد سحب ايران من أمريكا مفاصل السلطة في العراق . والثانية أن القوة الروسية لاتماثل قوة الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية والمالية المتحالفة مع أوربة . والأهم مما سبق أنه أخطأ في تقدير رد فعل الشعب الأوكراني واستعداده للخضوع للقوة الروسية . وأخيرا أنه لم يدرك كم تغير العالم بعد الحرب العالمية الثانية , وأن محاولة إعادته إلى أجواء تلك الحرب انطلاقا من أوربة ستقاوم برد فعل قوي وشامل . لقد أخطأ بوتين الحساب هذه المرة , ولا شك أن الثمن سيكون فادحا على روسيا وأوكرانيا والعالم .
———————
الحرب على أوكرانيا والفانتازم العربي/ كمال الرياحي
كتبت منذ سنة تقريباً مقالاً بعنوان “حبيبنا كيم جونغ أون… عن الشبق الدامي وشوق العرب إلى الديكتاتورية”، حلّلنا فيه الخطاب الشعبي في تلك الأيام التي اختفى فيها دكتاتور كوريا الشمالية وقتها.
وكان العرب قد أغدقوا عليه بالمديح والتمجيد، واختبأ معظمهم وراء الفكاهة، ولكننا نعلم أيضاً أن الفكاهة أسلوب صار معروفاً عندنا لنخرج لاوعينا وفانتازماتنا ونشرع إعلانها دون مساءلة. ويبدو أنه منذ سقوط صدام حسين والقذافي ظل ذلك الشبق مكبوتاً، ويتفجّر كل مرة مع ظهور طاغية جديد، فرأيناه مع كيم جون أون ووحشيته، ورأيناه مع ترامب عندما كان يذلّ هم، واليوم نراه مع بوتين، حيث أغرقت الحشود وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الخطابات الشبقية والغزلية لهذا الطاغية الجديد، الذي اجتاح بلداً آمناً وشعباً يكابد بحثاً عن نجاة من مشاكله الاقتصادية والسياسية.
الموقف الرسمي المخجل
ظلت الحكومات العربية صامتة، تعضّ على ألسنتها وهي تشاهد الجريمة النكراء التي تحصل أمام أعينها وسقوط آلاف الضحايا، بسبب تعنّت دكتاتور يمتلك أسلحة للدمار الشامل ونزوعاً لاستعادة مجد إمبراطوري بائد. لم يحرك القادة العرب ساكناً إلى الآن، منتظرين أوامر أسيادهم، فهم يأتمرون بأمرهم، بل إن تونس مثلاً كان موقفها مخجلاً عندما أعلنت أنها تقف على الحياد. إن هذه الجريمة الإنسانية التي يتابعها العالم لا يمكن فيها أن نقف على الحياد، لأن الحياد تجاه معركة غير متكافئة هو اصطفاف غير معلن مع القوي.
ويمكن أن نفهم هذا الموقف الغريب بالرجوع إلى حيثيات عامة، فقد كانت الدبلوماسية التونسية، عبر تاريخها، تتحدث عن الشرعية الدولية والتي هي في صالح أوكرانيا المعتدى عليها، بينما الوقوف على الحياد موقف جديد لديكتاتورية ناشئة، يحاول أن يرسي قواعها الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد. وهو أيضاً موقف نابع من الخلاف بين الغرب الأوروبي والأمريكي والكندي من إجراءات قيس سعيد وانقلابه على الدستور منذ 25 تموز/ يوليو. وكأنه بهذا الموقف يرد على مواقفهم منه ومن إجراءاته الاستثنائية وهو يبحث عن شريك جديد.
هذا الموقف التونسي المخجل من الحرب على أوكرانيا وازاه موقف سافر وأكثر عاراً، متمثل في موقف نظام بشار الأسد الذي ارتمى في حضن الدبابة الروسية منذ اللحظات الأولى، وهو بذلك يأتمر بأوامر سيده بوتين الذي استجار به لقمع انتفاضة شعبه.
أما الموقف الليبي المندّد بالغزو والموقف اللبناني على نبله، نعلم أنه أيضاً ليس موقفاً حراً بقدر ما هو اصطفاف لوضعية البلدين سياسياً واقتصادياً وعلاقتهما بالمعسكر الغربي، ولكنه من حسن حظهما هو اصطفاف مع الإنسانية. فمهما كانت دوافع الحرب فهي مدانة دائماً.
الحشود السادية
أما مواقف الحشود فهي الأخطر، فقسم كبير من الجماهير العربية تمدح حرباً لا ناقة لها فيها ولا جمل، فقط هي تمارس شبقها التاريخي وشوقها الأبدي للذكر العنيف. شعوب افتقدت لوطء الطاغية، ذلك القائد القوي الدموي الذي يجلدها ويستثير عواطفها بالعنف.
جانب آخر منهم وصل به الأمر إلى فبركة فيديوهات للأوكرانيات والتندّر بهن وترويج أخبار عن وصولهن لمطار تونس قرطاج، مستندين على ثقافتهم الذكورية والدينية المشوهة.
هذه الحشود السادية المتشوقة للألم لم تعد تطيق انتظارها فحولته إلى فانتازم، واندفعت تبحث عنه في قادة شعوب أخرى عندما فشلت في صناعته. إنهم يتلذذون برؤية دبابة روسية تسحق مواطناً في سيارته، بل إن بعض المنتسبين إلى الثقافة راحوا يبررون اجتياح بوتين لأوكرانيا بالتصغير من شأن رئيسها، على اعتبار أنه كان ممثلاً كوميدياً، وبذلك لا يحق له أن يدير البلاد أو أن يصل السلطة. نسى هؤلاء أنه منذ سنة فقط كان حبيبهم ترامب، الكومبارس في الأفلام، رئيساً للولايات المتحدة، ونسي هؤلاء أن في الماضي البعيد كان ممثل أفلام الوسترن، رونالد ريغان، رئيساً لأمريكا. فجأة صار التمثيل عورة سياسية عندهم.
يبدو أن هذا الموقف من مدنية الرئيس وارتباطه تاريخه الشخصي بالفن نابع من إيمان عند هذه الحشود بأن القائد عليه أن يكون عسكرياً، كما كان صدام حسين وجمال عبد الناصر وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي وعبد الفتاح السيسي وغيرهم من قادة بلدان العرب.
إن التأمل في كل هذا الخطاب الجماهيري والمخيال الشعبي للزعيم يطرح أسئلة أخطر متعلقة بمدى مقدرة هذه الشعوب على انتزاع حريتها. شعوب تسخر من الشعوب الضعيفة، وتشرّع لسحقها ومحقها من جيرانها، وتسخر من القادة السلميين، وخاصة منهم من كانت له تاريخ ثقافي.
إن الحشود العربية في مجملها عندها عداء خاص تجاه الثقافة والمثقفين، وتعتبرهم زوائد عن الحاجة وعالة عليهم، والأجدر أن تمحى وزارات الثقافات وتحول إليهم ميزانياتها، مع أن تلك الوزارات نفسها منخرطة في نظام إبادة المثقفين. الكثير من صناع المحتوى والمؤثرين في العالم العربي انخرطوا في حملة السخرية البشعة، أما المثقف العربي، للأسف إلى الآن، يبدو إما صامتاً أو متورطاً في هذه الكوميديا السوداء التي تديرها الحشود، مقابل الكوميديا السوداء الحقيقية التي تعيشها الإنسانية.
الروائي أندريه كوركوف وموقف المثقف
كان الكاتب الأوكراني الشهير أندريه كوركوف مستاء من مآل الثورة الأوكرانية أو ما يعرف الثورة البرتقالية (أواخر نوفمبر 2004 حتى يناير 2005) في أعقاب جولة إعادة التصويت على الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وظل يسخر في رواياته منها، فلئن حققت بعض الانجازات السياسية، فإنها لم تستطع أن تخلص الأوكرانيين من وضعهم الاقتصادي المزري، بل زادته سوءاً، كما ضربت وعياً باطنياً بالانتماء إلى الاتحاد السوفياتي. يقول في حوار قديم: “بالنسبة إلي، من الصعب أن أصدق أن الاتحاد السوفياتي لم يعد موجوداً، ومازال لدي إلى الآن بعض الحنين، كنت أسافر كثيراً، وبين ليلة وضحاها أصبحت بعض الأماكن التي كانت وطني بلداً آخر، انقطعت لسنوات عديدة عن الذهاب الى موسكو، كانت طريقتي للاحتجاج على وضع حدود بين روسيا وأوكرانيا”.
يكتب كوركوف بالروسية، وفي روايته “عزيزي صديق المرحوم” يداور عبر التخييل هذه الأزمة في كوميديا سوداء. فتروي الرواية قصة توليا، مترجم فاشل قرر الانتحار بعد اكتشاف خيانة زوجته بسبب الفقر والخصاصة، غير أن توليا يكتشف أن الانتحار لا يحقق له الاشباع الكافي الذي رامه من خلال عملية تغييبه من الحياة، فيؤجر قاتلاً محترفاً لتصفيته. غير أن ظهور لينا أربك خطته، لأنه أعاد إليه الرغبة في الحياة، وتنطلق الرواية من جديد في جو بوليسي كافكاوي ساخر لمحاولة استعادة الحياة التي أمر البطل ودفع من أجل التخلص منها. ويصطدم بواقع “فات الأوان”، فالقاتل المأجور انطلق في تنفيذ المهمة، وهو صاحب ضمير ولا يمكن أن يتراجع أو يتقاعس عن أداء مهمته أو التلاعب بسمعته كقاتل محترف، فلا يجد توليا من حل غير تكليف قاتل ثان بقتل القاتل الأول، فتتشابك الأحداث وتتعقد الأمور، وتتحرك الدماء المتجمدة في حياة الشخصية التي كانت تعيش حالة من اليأس والجمود الناتج عن تراكم الخيبات من حوله. ليحمله القدر إلى عشق جديد ينسيه خيانة زوجته له، حب ينبت في السواد بينه وبين زوجة من أجّره لقتله فقتله.
إن موقفه النقدي من الثورة ومن تفكك الاتحاد السوفياتي وكتابته بالروسية لم يدفعه إلى الارتماء في أحضان الروس، بل وقف مدافعاً عن بلده وهو الآن تحت القصف، متنقلاً بين الفنادق والملاجئ كأي مواطن أوكراني.
وككل كاتب شريف وأصيل، يوقف كوركوف العمل على روايته الجديدة ويتحول إلى مراسل حربي وداعم لشعبه وجيش بلاده، من خلال تغريداته الحينية على تويتر أو عبر حواراته مع الصحافة الأجنبية.
هكذا يضع كوركوف نفسه على ذمة بلده بطريقته، غير عابئ بما يمكن أن يحدث له لو سقط في أيدي الروس، وهو المعروف عندهم وجهاً ونصاً.
إبان الثورات والحروب، يتوقف الروائيون عن إنهاء مشاريعهم الروائية القائمة على التخييل والبناء، ليذهبوا إلى الكتابة الصحفية أو كتابة اليوميات، أذكر جيداً تلك الأشهر التي شهدت الانتفاضات العربية عندما تحول بعضنا، بعض الكتاب، إلى مراسلين وكتاب يوميات، وقتها تحدثت مع الروائي الليبي محمد الأصفر، الذي كان يتابع تحرير ليبيا من بنغازي ويعايش الثوار، وكنت في تونس أراسل الصحف الإيطالية والأمريكية في سلسلة من اليوميات. تناقشنا وقتها عن استحالة الكتابة التخييلية في واقع أشد من التخييل رعباً، وواقع متحرك تحت أقدامنا، علينا أن نمسك لحظاته لحظة بلحظة ونسجله للمستقبل. هكذا اليوم يفعل كوركوف في أوكرانيا، وما يمثله اسمه من ثقل في العالم، عبر إنتاجه الغزير وقرائه في كل مكان، ليكون منبراً قوياً يروج للقضية الأوكرانية في ظل التعتيم الإعلامي والترسانة الإعلامية الروسية.
لا يتردد الروائي في أحد حواراته الجديدة مع “تيليراما” في نقد السياسة الأوكرانية وافتقارها إلى مدرسة سياسية تمكنها من رعاية مصالحها بين القطبين الغربي والروسي، والعيش بسلام بجوار شخص مثل بوتين، واعتبر صاحب “عزيزي صديق المرحوم” أن المنطقة تعيش عودة البلشفية.
من الغريب أن آخر رواياته “النحل الرمادي” تدور أحداثها حول الجيران الأعداء أو “أصدقاء – أعداء” سيرجيتش، مربي النحل المخلص لأصوله الأوكرانية، وباشكا صاحب القلب الذي يميل نحو الانفصاليين. وتحت القصف ونيران القناصة، تتدافع أحداث شبيهة بما يجري اليوم بين أوكرانيا وروسيا، وأثر ذلك على الأبرياء.
إن هذا النزوع إلى الحرب هو نزوع إلى البدائية، والجانب الحيواني فينا يتعاظم كلما شعرنا بأننا أكثر قوة من الآخرين، ما يشرع لنا طمسهم أو استعبادهم أو انتهاكهم، وهذا ما تفعله روسيا اليوم، وما فعلته ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وما فعله صدام حسين بغزو الكويت.
ومن ثم، فواجب الإدانة واجب إنساني قبل كل شيء، غير أن المصالح الصغيرة لبعض الأنظمة تحجب هذا الواجب أو تحظره، لكن الشعوب التي كانت دائماً ناطقة بذلك الصوت المكتوم؛ صوت الضمير الإنساني، صارت اليوم بفعل سياسة التجهيل ونشر العنف وثقافة التشفي، أصبحت شريكة في إنتاج هذا الدمار البشري العام. ولم تعد مراجعة كتاب “أفكار لأزمنة الحرب والموت” لسيجموند فرويد وألبيرت أنشتاين، كافية لفهم هذا الكائن البشري وشوقه الشبقي لإراقة الدم.
رصيف 22
—————————

الغزو الروسي لأوكرانيا… “عقاب” موسكو في دمشق أيضاً/ يامن المغربي
تمتد آثار الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ملفات عدة، من بينها الملف السوري المرتبط ارتباطاً مباشراً بكل من روسيا وإيران. فما إن بدأ الغزو، حتى أعلن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، دعمه لروسيا عبر اتصال هاتفي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال فيه وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن الخطوة الروسية “تصحيح للتاريخ”.
التأثيرات المتوقعة تشمل المسارين، السياسي والاقتصادي، فالعقوبات المتزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوري المنهك أصلاً، كما أن سوريا ستكون ورقةً للتفاوض على الطاولة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الأيام المقبلة.
ويدُرك النظام السوري التأثير الاقتصادي تحديداً، وسرعان ما أعلن عبر مجلس الوزراء عن “استجابته للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية”، وذلك للتخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة، حسب ما نقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في سوريا في “فيسبوك”.
تأثير سياسي محدود
حاول النظام السوري تصوير نفسه كـ”شريك سياسي” لروسيا في حربها على أوكرانيا، وبدا هذا الأمر جلياً في تصريحات المسؤولين السوريين، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى وزير خارجيته فيصل المقداد، وصولاً إلى نائب المقداد، بشار الجعفري، وكلهم أدلوا بتصريحات داعمة للرئيس الروسي، بل وصل الأمر بالجعفري للقول إن النظام السوري “استعد قبل شهرين لبناء علاقات مع إقليمَي دونيستك ولوغانسك”.
التأثير السياسي يكمن فعلياً في أن الملف السوري ربما يكون “ورقة تفاوض” بيد الروس في أي مفاوضات مقبلة حول أوكرانيا، خاصةً مع سيطرة القوات الروسية على مرفأ طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يمثل وصول روسيا إلى “المياه الدافئة”.
إلا أن هذه النظرية ليست بالضرورة صحيحةً في المطلق، إذ يرى المحلل السياسي حسن النيفي، في حديث إلى رصيف22، إنه وعلى الرغم من وجود تقاطعات عديدة بين دور روسيا في كل من سوريا وأوكرانيا، إلا أن هذه التقاطعات “لا توحي بتلازم التحرك الروسي في دمشق وكييف معاً”.
ويأتي رأي النيفي بحكم أن الملف السوري بات مرتبطاً بمسارات محددة كجنيف وأستانة ولقاءات اللجنة الدستورية، وبناءً عليه من المستبعد وفق ما يقول، أن نشهد تحركاً مفاجئاً في تلك المسارات.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قال بعد لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في موسكو في 24 شباط/ فبراير الحالي، إنه يأمل بألا تؤثر الأحداث الدولية الأخيرة على الأمور المتعلقة بسوريا.
وتدل تصريحات بيدرسون على ارتباط الملف السوري -ولو بشكل غير مباشر- بالملف الأوكراني، خاصةً مع ارتباطه سابقاً بملفات إقليمية، كملفي ليبيا وكاراباخ في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، ودخول الملف كورقة تبادلية بين اللاعبين الدوليين والإقليميين.
هذا الارتباط يعني أن الرد الأمريكي-الأوروبي على الغزو الروسي ربما يكون في سوريا، وليس من الضروري أن يكون هذا الرد عسكرياً بشكل مباشر. إلا أن النيفي يستبعد فكرة الرد في سوريا، “إذ يمكن القول إن التغوّل الروسي في سوريا جاء نتيجةً للتفويض الأمريكي الروسي، وتالياً فات أوان الرد هناك”.
ويضيف: “لا توجد معطيات تشير إلى احتمال عودة المشهد السوري إلى واجهة الأحداث، والسبب أن المعارضة وبحكم دورها الوظيفي، لا تمتلك أي مبادرة من شأنها أن تجعل القضية السورية ذات حضور في المشهد الدولي، وعليه لا يمكن التعويل على العوامل الخارجية”.
اقتصاد منهك… وبعد
تمثل روسيا منفذاً لتخفيف أثر العقوبات الدولية على النظام السوري، لذا فإن العقوبات الجديدة التي استهدفت روسيا بعد غزوها أوكرانيا تمثّل مصاعب اقتصاديةً للنظام، الذي يملك بدوره اقتصاداً منهكاً.
ووصل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف و660 ليرةً للدولار الواحد، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص في أسعار الصرف والعملات، فيما سبق وقدرت الأمم المتحدة أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري في 24 من شباط/ فبراير الحالي، عن حزمة قرارات جديدة وصفتها بـ”الضرورة الحتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة”، وشملت القرارات في ما يخص القطاع المالي والمصرفي، “الترشيد في الإنفاق العام والترشيد في تخصيص القطع لتلبية الاحتياجات”، معترفةً في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، بالصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري جراء النقص في الموارد الأساسية كالنفط والقمح، وهاتان المادتان تحديداً تستوردهما حكومة النظام السوري من روسيا.
يقول الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر لرصيف22، إن “الاقتصاد السوري بدأ بالتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا وفق بُعدين، الأول هو البعد العام (تأثر الاقتصاد العالمي بالغزو والذي يظهر من خلال ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وارتفاع سعر الغذاء)، وهو ما سينهك الاقتصاد السوري المتعب أساساً”.
أما البعد الثاني وفق السيد عمر، فيتمثل في أن الغزو والتوتر في البحر الأسود والتوتر الدولي سيصعدان من أزمة النظام السوري المحاصر، ما “سيؤثر بشكل مباشر في قدرته على توفير المستلزمات، كما أن النظام المصرفي الروسي يوفر للاقتصاد السوري بعض الخدمات، وفي ظل العقوبات الغربية على البنوك الروسية سيفقد النظام هذه الخدمات”.
وحدة حال العقوبات
ويرى السيد عمر أن العقوبات على روسيا ربما تزيد من وضع النظام السيء، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس الوزراء، ما يدل على أن النظام يتوقع بأنه لن يكون في مأمن من تأثير هذه العقوبات.
من جهته، يقول الأكاديمي والاقتصادي السوري، فراس شعبو، لرصيف22، إن “التأثير بدأ مباشرةً، إذ أعلن النظام السوري عن حزمة تقشفية جديدة من خلال ضبط النفقات بشكل كبير”، ويضيف: “سوريا اتخذت قرارات على مستوى الإنفاق والدعم الحكوميين، وتالياً إزالة أي دعم جديد وحالات رفع الدعم ورفع الأسعار، عدا عن ارتفاع الدولار وارتفاع الأسعار بسبب حالة الفوضى العالمية بما يخص النفط والذهب وأسعار السلع، وبالتالي ستتأثر سوريا بطبيعة الحال بارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً فيها”.
وستعاني روسيا من عقوبات شديدة جداً، خاصةً إن حُيّدت نهائياً عن النظام المصرفي العالمي والقدرة على بيع الغاز والنفط الروسي، وعلى الرغم من ذلك، فإن شعبو، لا يميل إلى فكرة أن القوى الغربية ستفرض عقوبات أكبر -خاصةً أن روسيا هي جزء من النظام العالمي- عبر إخراجها من نظام “السويفت” الذي يقتضي التصدير والاستيراد بطبيعة الحال، فهذا يعني خسارة للنفط والغاز وغيره، وتالياً لو منعت القوى الغريبة روسيا من بيع الغاز، ستلجأ الأخيرة إلى بيعه في السوق السوداء بأضعاف ثمنه”.
وعليه، يرى شعبو أن روسيا تدرك العقوبات الاقتصادية المقبلة وبعض المشكلات التي ستحصل في الاقتصاد الروسي، وربما حينها تكون سوريا ورقة تفاوض في أي ملف في الأيام القادمة وليست ورقة نفوذ، خاصةً مع وجود عقوبات كبيرة على سوريا بالإضافة إلى أنه لا يوجد رضا عالمي عنها.
من غير المعروف مدى تأثر النظام السوري بالعقوبات الجديدة على روسيا، إلا أن تعنت النظام وإعلانه الدعم لروسيا بشكل مباشر، وتشابك الملفات الدولية ببعضها البعض، أسباب تضعه على قائمة المتأثرين.
رصيف 22

======================
تحديث 01 أذار 2022
——————-
العلّة ليست في بوتين وحده/ راتب شعبو
يحتاج النظر في الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الفصل بين مستويين: الإدانة الأكيدة للاعتداء الروسي على سيادة دولة وحقوقها، وعلى أمان شعب وسلامته وحياته، والتضامن الأكيد مع هذا الشعب، ولا يوجد في العالم أحد يستطيع أن يفهم ويشعر بحال الشعب الأوكراني اليوم، أكثر من الشعب السوري الذي ينتمي له كاتب هذه السطور. المستوى الثاني فهم تكون شروط انفجار الحرب وسياقها، من دون الاستسلام إلى إغراء الاختزال بثنائية فقيرة، وإن تكن مريحة، فيبدو أنّ طرفي الصراع المندلع هما الديمقراطية وأعداؤها، وأنّ السبب الأساسي لاندفاع العدوانية الروسية هو اقتراب الديمقراطية (وليس اقتراب حلف الناتو) من حدودها، كما يقول بعضهم مدللين على قولهم إنّ “الناتو” موجود سلفاً على حدود روسيا في جمهوريات البلطيق، من دون أن ينتبه هؤلاء إلى أنّ الديمقراطية أيضاً موجودة سلفاً على حدود روسيا، ممثلةً في هذه الجمهوريات نفسها. وإذا كانت الحجّة أنّ أثر الديمقراطية في أوكرانيا على روسيا أكبر، يمكن القول إنّ لوجود أوكرانيا في الحلف أثراً أكبر على روسيا أيضاً. وهناك من يختزل الأمر في القول إنّ دافع التحرّك العسكري ضد أوكرانيا هو النزعة التوسعية الروسية، من دون أيّ إضافة، كما لو أنّها أمر مستجد أو خاص بقوة عظمى دون غيرها.
لا يصحّ اعتبار أنّ طبيعة النظام الروسي، البعيد عن المعايير الديمقراطية، أو أنّ الطبيعة الشخصية التسلطية للرئيس فلاديمير بوتين، ونزوعه إلى إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية، هما ما يفسّر الاعتداء الروسي على أوكرانيا، فالديمقراطية في أميركا لم تمنع الرئيس جون كينيدي من التهديد بإشعال حرب عالمية ثالثة ما لم يسحب الاتحاد السوفييتي الصواريخ التي نصبها في كوبا عام 1962، ولم تمنع الديمقراطية أميركا من اعتبار أميركا الجنوبية حديقة خلفية لها، بكلّ ما يعني هذا من تحكّم ومن نشوء أنظمة حكم عجيبة، صارت مادة لأدب أميركي لاتيني عالمي. كما أنّ الديمقراطية في بريطانيا لم تمنعها، مثلاً، من غزو جزر فوكلاند (أو المالفيناس) في 1982، لتأكيد سيطرتها على الجزر. في الأمر مصالح أمنية استراتيجية لقوى كبرى، وهذه مستقلّة إلى حد كبير عن نوعية النظام الحاكم أو شخصية الرئيس فيه.
في عالم اليوم، توجد أنظمة ديمقراطية تستقرّ على علاقات قوى داخلية، فيها قدرٌ جيدٌ من تقييد السلطات لصالح حضور مؤثر للرأي العام والمجتمع المدني والقيم الديمقراطية، ما ينشئ توازناً معقولاً في العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع. وتشكّل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية المجال الأهم لحضور هذه الأنظمة. كما توجد أنظمةٌ تسلطيةٌ يكون المجتمع فيها مكبلاً، بحدود متفاوتة، تجاه السلطة التي تستولي على المجال العام، وتميل إلى تأبيد ذاتها، وتشكّل روسيا والصين المجال الأبرز لهذه الأنظمة. فقد عدّل بوتين الدستور ليتمكن من الاستمرار في الحكم حتى 2036، كما عدّل الرئيس الصيني شي جين بينغ الدستور وصار يمكنه الاستمرار في الرئاسة مدى الحياة، غير أنّ العلاقات الخارجية لهذه الدول الكبرى تحكمها أساساً المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية، أكثر مما يحكمها شكل النظام السياسي فيها. لا يحتاج الأمر إلى التذكير بأنّه كثيراً، أو غالباً، ما وقفت الديمقراطيات الغربية داعمةً لأنظمة ديكتاتورية في غير مكان، وشنت حروباً لإسقاط سلطات منتخبة.
السعي الأميركي إلى إغراق روسيا “في المستنقعات” مستمرّ، وما يجري في أوكرانيا يشبه ما جرى ويجري في سورية، فهو يندرج في السياق نفسه، وإن كانت الحلقة الأوكرانية أكثر خطورة، بسبب موقعها الجغرافي الأوروبي. تقوم السياسة الأميركية على إنشاء شروط الحرب في بقعةٍ ما، مستفيدة من عناصر محلية محقّة وعادلة، ثم الاستثمار في الصراع المشتعل، والعمل على ضبطه ومنع انتشاره. وميزة هذا النوع من الصراعات، التي تجتهد أميركا وتساهم في إيجاد شروط اندلاعها، أنّها تعود بمكاسب لأميركا في كلّ حال، وكيفما مالت النتائج، على أنّ أميركا تحرص، كما نشهد في سورية وفي العراق واليمن وليبيا، على إبقاء الصراع مستمرّاً تحت عتبة الحسم. ومن المرجّح أن تدخل الحرب في أوكرانيا هذه الحال أيضاً، كما “تنبأ” الرئيس الفرنسي بالقول: “الحرب في أوكرانيا ستطول”. ومن المفهوم أنّ في ذلك عزلاً وإرهاقاً عسكرياً واقتصادياً لروسيا، وفيه شدٌّ لعصب الناتو، حتى إنّ بلداناً حيادية تاريخياً مثل السويد وفنلندا بدأت تفكر، على وقع العدوانية الروسية، بالانضمام إليه. هذا في حين كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد قال، في بداية ولايته الرئاسية، إنّ “حلف الناتو مؤسسة عفا عليها الزمن”، وتردّد أنّه يريد الانسحاب من الحلف.
لا نتجاوز على المنطق إذا قلنا إنّ السياسة الأميركية حيال روسيا (عدم احترام المجال الحيوي لقوة عظمى) ساهمت في تهيئة التربة المناسبة لبروز أمثال بوتين، الذي خاطب الشعب الروسي قبيل غزوه أوكرانيا باللغة التي لها مستقبلات خاصة عند الروس عبر التاريخ: “من أين تأتي هذه الطريقة الوقحة في التحدّث من موقف الهيمنة والفوقية؟ من أين يأتي الموقف المستهتر والازدرائي تجاه مصالحنا والمطالب المشروعة المطلقة؟”. وقد كان يمكن إحراج بوتين لو تعهدت أميركا أو أوكرانيا بعدم انضمام الأخيرة إلى “الناتو”. وحماية أوكرانيا من غزو روسي لا تحتاج دخول حلف الناتو، فلم تكن الكويت في حلف الناتو حين دخلت أميركا حرباً واسعة لاستعادتها من العراق، كما أنّ “الناتو” تنكّر لتركيا، وهي عضو فيه، ووجدت نفسها وحيدة إزاء روسيا في أزمة إسقاط الطائرة الروسية في 2015، غير أنّ الإصرار الأميركي ودفع أوكرانيا إلى رفض التعهد هما من سياسة إنتاج شروط الحرب، وقد لاحظ العالم التخلي الأميركي وخذلان أوكرانيا مع اندلاع الحرب.
ولا نتجاوز على المنطق إذا قلنا إنّ السياسة الأميركية حيال الثورة السورية (تساهل مع بروز التيارات الجهادية ثم مع التدخل الروسي) ساهمت في وصول الحال السوري إلى هذا الحضيض. وليس في هذا كله خطأ سياسي في الحسابات، بل هو بالأحرى سياسة محدّدة، غايتها إبقاء العالم في حالة إنهاك وحاجة مستمرّة إلى السلاح. الحروب المحصورة هي حاجة مستمرة للنظام العالمي المختل الذي نعيش فيه، فالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الأكثر إنتاجاً للأسلحة، ويمكننا إذاً أن ندرك ما هو “الأمن” في منظورها.
صحيحٌ أنّ النظام الروسي تسلطي يساند الطغم المستبدة، وأنّ الشعب السوري من بين أكثر الشعوب التي ذاقت الويلات على يد هذا النظام، الحليف للنظام الكيماوي السوري. مع ذلك، لا مهرب من رؤية علاقات القوى الدولية وصراعاتها المستقلة بصورة شبه تامة عن مصالح الشعوب، لا بل المعادية لمصالح الشعوب. النظام العالمي بقطبيه، الديمقراطي والمستبدّ، يجعل من المطالب العادلة والمحقة للشعوب عناصر للاستهلاك، ومن الشعوب مادّة للقتل وللتشرّد والبؤس، في ماكينة الصراع فيما بينهما. ومن العبث التعويل الجدّي على أيٍّ منهما في الصراع لترسيخ شروط حياة أفضل.
العربي الجديد
————————-
هل يقرأ السوريون الدرس الأوكراني؟/ بسام يوسف
بعيداً عن الوقائع اليومية لمجريات الحرب الدائرة في أوكرانيا، وبعيداً عن نتائجها التي يكثر التحليل والتنجيم فيها، وبعيداً عن مدى ترابط الساحة السورية بهذه النتائج، لكون روسيا التي تقف اليوم في وجه أهم القوى العالمية، هي اللاعب الأهم في سوريا، بعيداً عن هذا كلّه، فإن هناك حقيقة واضحة يجمع عليها كل السياسيين والمثقفين وصنّاع القرار في العالم، وهي أن العالم بعد هذه الحرب سيختلف كثيراً عما قبلها، كيفما كانت نتائجها.
إذاً، ومهما تكن نتائج الحرب الروسية – الأوكرانية، فإن ترتيباً جديداً للعلاقات الدولية على أسس تختلف عمّا هي عليه الآن سيكون ضرورة، وسيعود سباق التسلح مرة أخرى إلى واجهات اهتمام الدول، وستصاغ معادلات اقتصادية جديدة، وربما تحالفات جديدة اقتصادياً وعسكرياً، وأوروبا التي بدت وحدتها هشة وقابلة للانفراط، توحدها اليوم روسيا البوتينية وتقف وجها لوجه أمام السؤال الذي تجاهلته طويلا وهو إلى أي حد يمكن الوثوق بأميركا، وإلى أي حد يمكن لها أن تبقى تابعة ومرتهنة للقرار الأميركي وللقوة العسكرية الأميركية؟
إذا كانت كل المؤشرات تذهب إلى توقع أزمة اقتصادية عالمية، وأزمة غذاء وطاقة، ومزيد من الحروب، فما الذي سيُبقي الملف السوري حاضراً على طاولة الدول الكبرى؟ وهل من العقلاني أن يستمر السوريون في انتظار الآخرين لحل مشكلتهم؟ وهل يمكن الركون إلى من يحكم سوريا اليوم؟ والذي يزج بها وبحماقة بالغة في حرب أوكرانيا، وكأنه لم يكتف بتدميرها وتهجير شعبها، واستقدام جيوش متعددة إليها، وبيع أو رهن ثرواتها، يُسارع في هذه اللحظة التي يحبس فيها العالم أنفاسه خوفاً من حرب عالمية ثالثة، ليضعها وبمنتهى الغباء والتبعية، في موقع تبدو فيه وكأنها طرف في حرب تستعر بجنون، ولا يعلم أحد إلى أين ستصل، فهل سيصمت السوريون طويلا على تحويل بلدهم إلى مجرد ساحة لصراع الآخرين عليها؟
الأخطر من هذا، ليس فقط تراجع الاهتمام بسوريا، وليس فقط ذهاب الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإبقاء على الوضع الراهن، متجاهلين مأساة السوريين وانهيار كل مقومات الحياة لديهم، الأخطر هو أن تحاول هذه الأطراف استعمال سوريا كساحة حرب لتخفيف الخسائر عن بلدانها، ونهب إمكاناتها لتدعيم اقتصاداتها أو حربها.
في ضوء ما تقدم، يُمكن القول إن أحداً لن يفكر في المدى المنظور بحل المعضلة السورية، وأن أحداً لن يقدم على المساهمة في إعادة إعمارها، فالأولوية الآن للحرب المجنونة التي تلقي بظلالها المخيفة على كامل مساحة كرتنا الأرضية، وبعدها – ومهما تكن نتائجها- فإن الأولوية التي سيتصدى لها العالم، ستكون ترميم ما سوف تدمره هذه الحرب من اقتصادات ودول، وما سوف تفرضه المعادلة الجديدة من أعباء وميزانيات.
في المعادلات التي ترتسم في الأفق، سيكون من الحماقة البالغة أن تكون سوريا مرتهنة لأبشع نظامين في العالم، أقصد “الروسي البوتيني”، ونظام “الملالي الإيراني”، وإن بقاء سوريا في تبعية كاملة لهاتين الدولتين هو نهاية لها، فهل يُسارع السوريون لفهم المعادلات الجديدة، والدخول في شراكات حقيقية تتيح لهم إعادة إعمار بلدهم، والخروج بأقل خسارة من مأزق ما يزال يطبق عليهم؟ ولا يلوح في الأفق أي نهاية له، إذا ما استمرت مقاربتهم للعلاقات الإقليمية والدولية بالطريقة ذاتها.
العقبة الأساسية أمام إعادة تموضع سوريا في النظام العالمي الذي ولدته الحرب في أوكرانيا (والتي قد تتوسع في أي لحظة)، تتمثل في عائلة الأسد، التي لم تخرج لحظة من حساباتها الشخصية وهوسها بالسلطة وإدارتها المافياوية لها، والتي لم ترَ سوريا لحظة واحدة على أنها وطن وشعب يريد ككل شعوب الأرض أن يعيش حراً وكريماً.
لكن ورغم كل الظروف القاهرة التي يعيشها السوريون، فإن هذه العقبة اليوم هي الأضعف، وإن استمرارها في خطف سوريا كرهينة لاستمرارها في الحكم، لا ينبع من قوتها، بل ينبع أساساً من ضعف خصومها واستسلامهم، وعليه فإن أي حركة اليوم باتجاه إزاحة هذه الطغمة، هي أكثر جدوى وقدرة من لحظات كثيرة سابقة.
إنّ ضرورة إزاحة عائلة الأسد لا تتأتّى فقط من خيانتهم لوطنهم، ومن اعتبار السلطة أولوية مطلقة في حساباتهم، بل يتأتّى أيضاً من انعدام قدرتهم اليوم على فعل أي شيء لخدمة سوريا، فهم ليسوا أكثر من بيادق تحركها دول أخرى، وليسوا إلا مجرد تابعين لدول لا تهمها مصلحة سوريا، ولا الشعب السوري.
إن في تلاقي السوريين في الداخل والخارج، وفي الموالاة والمعارضة، وفي كل التصنيفات الأخرى على هدف إنقاذ سوريا دون أي تفاصيل أخرى، وفي حسن استغلالهم لهذه اللحظة التاريخية، للخروج من حالة الاستنقاع المدمرة نهاية كاملة لحقبة عائلة الأسد البغيضة، وإن أي قيادة جديدة لسوريا خارج عائلة الاسد، ستفتح حتماً مساراً جديداً لسوريا، وتفتح آفاقاً أرحب لاتفاق السوريين، والبدء بصياغة عقدهم الاجتماعي الجديد، وصياغة دستورهم، وخلق آليات ناظمة لاختلافهم يحكمها القانون والدستور.
في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية التي تحل قريباً، نتذكر أن أحد عشر عاماً مرت على سوريا، منذ أن حاول السوريون أن يخرجوا وطنهم من مأزق كبير، ورّطتهم به قيادة لم تر في السوريين ووطنهم إلا مزرعة وكرسي حكم، ونتذكر أن الأفق المغلق مايزال مغلقاً باتجاه حلول عملية تخرج سوريا من محنتها، وتقول الذكرى لنا ما هو أهم من كل هذا وهو أن سوريا ومأساة السوريين، على ضوء الحدث الأوكراني ستتراجع كثيراً في ترتيب قائمة اهتمام العالم، فإلى متى سيظل السوريون يعدّون السنوات بانتظار انتهاء هذه الكارثة؟
اليوم تحتاج سوريا إلى سوريين حقيقيين، لا يهم تصنيفهم سياسياً أو دينياً، أو أي تصنيف آخر لهم، يتنادون إلى تشكيل هيئة لإنقاذ سوريا، تقول للعالم إن حقوق السوريين في أرضهم، وإن سيادتهم هو حق خالص للسوريين، وإن عائلة الأسد التي أهدرت كرامة السوريين، ودمّرت سوريا، ولا يهمها شعب أو تاريخ، لم يعد لها دور.
إن الدرس الأوكراني البالغ الفصاحة والوضوح، والذي نتابع مفرداته لحظة بلحظة، هو أن الشعوب عندما تضع أوطانها نصب أعينها، قادرة على اجتراح المعجزات، إن لم تخنها قيادتها.
تلفزيون سوريا
—————————–
الأسد وزيلينسكي: المهرّج والكوميدي/ عمر قدور
حتى الأحداث الخطيرة الكبرى قد تتيح على هامشها فسحة للطرافة، خاصة لأولئك البعيدين عن موقع الخطر المباشر، أما مَن هم تحت القصف فيفوتهم ذلك الترفيه غير المتوقع الذي يحظى به جمهور المتفرجين. هكذا، مثلاً، من المؤكد أن الأوكرانيين “الذين يترقبون تصريحات وأفعال القادة الدوليين” لم يسمعوا باتصال بشار الأسد ببوتين غداة بدء الهجوم على بلادهم، ولا بأقوال الأول من قبيل وصفه الغزو بتصحيح للتاريخ وإعادة التوازن للعالم، أو قوله أن روسيا تعطي درساً للعالم باحترام القانون والأخلاق العالية والمبادئ الإنسانية… إلخ.
مستشارة الأسد لونا الشبل، في حديث إلى وكالة سبوتنيك الروسية، أكدت الوقوف إلى جانب موسكو في الحرب، ونُقل عنها الوعد بمساعدتها في التغلب على العقوبات الغربية ردّاً لجميلٍ مماثل. سبقتها مذيعة بالكتابة عن ذهاب وزير دفاع بوتين إلى حميميم كي يخبر الأسد بتفاصيل العملية العسكرية المقبلة في أوكرانيا، بصياغة يبدو فيها بوتين كأنه يستشير الأسد وينسق معه على مستوى استراتيجي. وكان الأخير قد سارع إلى الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين عن أوكرانيا بعد الاعتراف الروسي الذي كان بمثابة إعلان للحرب الحالية، وسبق فقط لأوسيتيا الجنوبية الاعتراف بهما، والأخيرة جمهورية مُقتطعة من جورجيا على منوالهما تماماً.
ثمة سعي من الأسد ليزج نفسه في الشأن الأوكراني، والحق أن اسمه صار متداولاً على نحو مختلف عما يريده، إذ حضرت المقارنة بينه وبين الرئيس الأوكراني زيلينسكي. فإثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا صدرت مقالات في صحف غربية كبرى، مثل الغارديان ولوموند، تربط بين ما يفعله بوتين هناك وما يفعله في سوريا، أو تقارن بين البلدين، وصولاً إلى التخوف من أن يتمدد صاحب الطموحات القيصرية على شواطئ المتوسط “جنوب أوروبا” انطلاقاً من قاعدته السورية. هذه الصحوة الغربية محكومة بجزء من الرأي العام منشغل بالقضية الأوكرانية باعتبارها شأناً أوروبياً داخلياً، الحرب داخل البيت لا في قارة أخرى، ومحكومة أيضاً بالاختلافات الفعلية والشكلية بين أوكرانيا وسوريا والتي ستعود إلى الصدارة كلما خفت حدة المواجهة على الجبهة الأوكرانية.
العدو المحتل واحد. هذا وجه التقاطع الأبرز بين سوريا وأوكرانيا، ليأتي بعده وجه الاختلاف الأكبر؛ الأسد ليس زيلينسكي. الأول لقمع الثورة عليه استدعى الاحتلال الروسي بعد الإيراني، والثاني رفض الانصياع لتهديدات بوتين، وقرر القتال من أجل الحفاظ على استقلال بلاده. الفرق ليس شخصياً فحسب، لأن كلاً منهما فعل ما فعله انطلاقاً من موقعه؛ وريث الاستبداد استعان بالأجنبي للحفاظ على كرسيه، بينما الرئيس المنتخب ديموقراطياً اتخذ القرار الوطني الذي تمليه عليه مسؤولياته إزاء ناخبيه وشعبه ككل. جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو “الذي خسر الانتخابات لصالح زيلينسكي” عاد إلى بلاده، وهو حسب الأخبار يقود كتيبة من المقاتلين ضد الاحتلال الروسي في دلالة أخرى على وحدة البلاد.
يُوصف زيلينسكي أحياناً برئيس الصدفة، الصدفة التي قادته من ممثل كوميدي إلى سدة الرئاسة. بشار أيضاً يوصف بأنه رئيس الصدفة، الصدفة التي أودت بشقيقه الأكبر في حادث سير فأتت به إلى وراثة أبيه. أداء زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة فاجأ المتابعين، فالممثل الكوميدي السابق تصرف كرجل دولة ناضج، وبهدوء يخلو من الاستعراض، وتحاشى الانزلاق إلى ردود أفعال على استفزاز بوتين، رغم أن الرد على شتائمه قد يُكسبه شعبية إضافية بين الأوكرانيين.
في سياق الشتائم، استخدم بوتين تعبير مدمني الحبوب “المخدرة” في وصف القيادة الأوكرانية، فضلاً عن تشبيه النزوع القومي الأوكراني المناهض للهيمنة الروسية بالنازية. إنهم نازيون ومدمنو حبوب مخدرات، هي شتيمة من أعلى مستوى في روسيا، غير أنها “وهذا وجه آخر للمقارنة” لا تساوي الشتيمة التي وجهها إعلام بوتين إلى بشار عندما وصفه بذَنب الكلب، فالشتيمة التي توجَّه إلى العدو تعكس العداء والغيظ، وربما محاولة حشد جمهور محلي مساند للحرب. أما الشتيمة الموجهة لحليف “أو تابع” فهي أقسى وأمضى، لأنها في منزلة الإهانة والتحقير، ولما لها من مصداقية صدورها عن صديق لا عن عدو. مشهود للأسد امتصاصه الإهانات الروسية العديدة والمتعمدة، وكما نعلم انطلاقاً من اعتبارات مغايرة تماماً لترفع زيلينسكي عن الرد على بوتين.
فولوديمير زيلينسكي ممثل كوميدي أوقعته الظروف في اختبار تراجيدي، فأظهر ما يكفي للرد على أنصار بوتين وعلى مبتذلي الصحافة الذين يصفونه بالمهرّج في خلط متعمد أو قليل المعرفة بين مهنتي الكوميدي والمهرّج. لطالما كانت الكوميديا فناً راقياً يخاطب العقول، ويشرّح بمبضع المفارقة والضحك قضايا ذات أهمية راهنة أو ذات أهمية وجودية، ما يجعلها أسلوباً للمعرفة يحتاج سوية عالية من أصحاب هذا الفن. أما التهريج فهو مهنة لها شرف إضحاك الجمهور بشرط ألا تُلصق بها ادعاءات أعلى مما هي عليه، ومن المستحسن أن يسميها أصحاب السلطة باسمها أثناء ممارستها فلا يعتبرونها سياسةً.
من الأمثلة الشهيرة عن التهريج مهرّج السيرك، وهذا يظهر غالباً بلباس وماكياج يتوخى الإضحاك على شكله قبل أدائه، وضمن فواصل يحتاجها العاملون للإعداد للفقرة التالية، ومفيدة للجمهور الذي ربما كان قد حبس أنفاسه وشُدّت أعصابه من متابعة بهلوانيات خطرة، أو مشاهدة ألعاب لا تقل خطورة مع الحيوانات المفترسة. المثال الآخر الشهير أيضاً هو مهرّج البلاط الذي قبل الترفيه عن ضيوف القصر يتواضع بإسفاف ليرضي غرور السلطان، وقد تلزم في هذا السياق ترجمة السلطان إلى قيصر.
لدينا مثال وقح جداً على من يلعب مهنة البلطجي والمهرج معاً في منصب “الرئيس الشيشاني”، وهو زلمة بوتين بعد سحقه انتفاضة الشيشان بأسلوب الأرض المحروقة. رمضان قديروف يؤدي دور الشبّيح كلما دعت الحاجة، وقد أعلن عن مشاركة عشرة آلاف من قواته في الحرب على أوكرانيا، ولا ينسى التهريج في الوقت نفسه، إذ ينقل عنه موقع RT الروسي وصفه العقوبات الغربية على روسيا بأنها خرافات بايدنية بلا جدوى، مضيفاً بتهريج عفوي: أعيش تحت كل العقوبات، وأعيش براحة. بدوره، قد يكون قديروف مضحكاً بلا تبعات تتجاوز اللحظة لجمهور آخر، أما بالنسبة للسوريين فهو يستدعي مقارنة أخرى أكثر وجاهة من المقارنة مع أوكرانيا.
————————

غزو الماضي/ عروة خليفة
لا تتيح تقنيات العالم الافتراضي المطوّرة حتى اللحظة تجربةَ العيش في عالمٍ موازٍ تماماً. وعلى الرغم من تسارع الاختراعات وتقدم التقنيات التي تتيح الكثير من الاستخدامات بدءاً من لعب لعبة الفيديو «Half-Life» الشهيرة لدى جيل الثمانينات في عالم ثلاثي الأبعاد، أو حتى إجراء عمليات جراحية عن بعد من قبل جراحين موجودين على بعد آلاف الكيلومترات، إلا أنّ تلك التقنية لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق خطوات كبيرة تدفع مستهلكين عاديين إلى العيش خارج حياتهم، في حيوات أخرى وواقع مختلف كليّاً، لا زالت أنصاف الحلول التقنية التي تعتمد على الخيال البشري هي المسيطرة.
بطريقة ما، تدبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمره للعيش بتجربة متكاملة من العالم الموازي الذي يصنع فيه امبراطورية مزيفة، يريد لها أن تكون قوّة عظمى مجدداً. هذا العالم الموازي يمتلك خصائصه المستقلة وموازين القوى المنفصلة عن واقع عالمنا، لكنّه حقيقي في كثير من أوجهه، إذ إنّ المدنيين الذين تقتلهم غارات الطيران الروسي يموتون فعلاً في عالمنا وليس في عالمه الموازي فقط، كما أنّ الخسائر في البنى التحتية والدمار الذي يحلّ على المدن يحدث فعلاً في عالمنا، والصواريخ النووية التي يهدد بها موجودة في عالمنا أيضاً وليس في عالمه فقط.
إلّا أنّ عالم بوتين يستقلّ بخصائص لوحده أيضاً، فهو يرتبط أكثر بالصورة التي يجري تقديمها لروسيا في البروباغندا التي تقدمها وسائل إعلام تابعة لموسكو أو لأحد حلفائها في العالم؛ مثل القنوات والمحطات الإيرانية وتلك التابعة للنظام السوري أو المقربة منه: صورة بوتين الذي يركب الحصان من دون قميص معيداً أمجاد امبراطوريات من القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أو صوره في لباس رياضة الجودو ملقياً الغرب الامبريالي وراء ظهر الدب الروسي الذي استفاق من سباتٍ دام لعقود. ذلك شيءٌ ستكون الجملة التي وصف بها بيان بشار الأسد غزو أوكرانيا تعبيراً دقيقاً عنه: «تصحيح لمسار التاريخ»؛ عبارة لا يمكن أن تتوقع قراءتها اليوم إلا خلال قيامك ببحث أكاديمي في التاريخ، لكنّها في عالم بوتين الموازي تقال اليوم، حيث الأزمنة تتماشى بشكلٍ موازٍ.
حتى اليوم الثاني من الغزو الروسي لأوكرانيا، بدا ذلك العالم الذي صنعه بوتين خلال سنوات حكمه لروسيا الاتحادية -الوريث الأكبر للاتحاد السوفييتي- بدا ذلك العالم الافتراضي ممكناً للكثيرين، إلى درجة أنّ البعض تورط لسنوات في التبشير به، والتبشير بديستوبيا تصبح فيها روسيا يحكمها بوتين قوّةً عظمى من جديد، فيما خشي الكثيرون من تكذيبه أو الصياح بأنّ بوتين عارٍ تماماً (ليس من القميص وحده).
المرحلة الأولى: خطوات حذرة في العالم الجديد
لكن قبل أن نحاول تلمس شكل هذا العالم الذي يصنعه خيال عميل سابق لجهاز الاستخبارات السوفيتي KGB، يجب أن نعرف كيف وصلنا إلى هنا، وما هي الأحداث التي شجعت ديكتاتوراً يحكم دولةً لا يتعدى ناتجها المحلي ناتج دولة أوروبية أصغر في المساحة وعدد السكان وأقل في الموارد الطبيعية، لأن يتخيل نفسه امبراطوراً في القرن الحادي والعشرين؟
بدأ الرجل مسيرته المهنية كرئيس لروسيا بارتكاب جرائم حرب فظيعة في الشيشان التي كانت تنتفض للحصول على استقلالها عن موسكو، وفشل سلفه يلتسن لأعوام في الوصول إلى نهاية لأزمة دولته التي لا تريد إعطاء أية فرصة للجمهوريات الصغيرة بتقرير مصيرها. ذلك العنف الصرف الذي أدّى إلى تدمير شبه كامل لمدينة غروزني الشيشانية وتنصيب جهادي سابق عليها كرئيس دمية، كان نصر بوتين الأول في عالمه الموازي؛ نصرٌ اضطّر عالمنا الحقيقي لدفع أثمانه من أرواح المدنيين ومن جدران منازلهم.
سيتطور مخيال الرجل الذي لم يكن أصبح ستينياًّ بعد لرؤية أي قرارٍ مستقل تتخذه دولة في جوار روسيا من تلك التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي تهديداً لـ«الأمن القومي لروسيا»، ليقوم بتحركات عسكرية محدودة للغاية بالتوازي مع تحريض حركات انفصالية، كما جرى في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الجورجيَّين عام 2008، وتكرّر ذلك بعد الاطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش المقرب من الكرملين عام 2014، ليقوم صاحبنا الذي تعدّى الستين بغزوٍ محدود لشبه جزيرة القرم، التي كانت مقراً تاريخياً للأسطول السوفييتي في البحر الأسود، مستدعياً ميليشيات انفصالية في أقصى شرق أوكرانيا لتقوم بتقديم غطاءٍ سياسي لتلك الاعتداءات.
لم تحظَ الاعتداءات الروسية حتى تلك اللحظة بأي ردود فعلٍ صارمة من أوروبا الغربية والولايات المتحدة التي اكتفت بعقوبات لم تكن لتضعف مكامن قوة الاقتصاد الروسي تماماً، والذي يعتمد على تصدير النفط والغاز. وبعد نجاح بوتين في المرحلة الأولى ضمن لعبته لصناعة إمبراطورية قديمة من جديد، ومن دون أي خسائر كبيرة، كان الانتقال إلى المرحلة الثانية أمراً ممكناً، خاصةً وأنّ هذا الانتقال لم يُواجه بأيّة معارضة جديّة، فانتقل بوتين إلى سوريا. سيغير موازين القوى العسكرية لصالح بشار الأسد مقابل قاعدة على المتوسط، حُلم أسلافه الأباطرة القديم، هو الوحيد من حقّق ذلك سيقول لنفسه.
المرحلة الثانية: بطل جديد في البلدة
لن تنجح قوات روسية صغيرة بتحويل الموقف عسكرياً، فيستدعي بوتين التجربة الشيشانية، لتقصف طائراته بطريقة وحشية كل ما على الأرض، بالتوازي مع استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، والقيام بعمليات تهجير واسعة للسكان، وجرائم حرب بالجملة، وقصف مركز يستهدف عن سابق قصدٍ وإصرار مواقع مدنية مثل المشافي والمدارس (كثيرٌ منها شاركت إحداثياتها الأمم المتحدة لتجنيبها القصف الروسي)، فانتصرت القوّة الصرفة لبوتين الذي أصبح متعلقاً أكثر بعالمه الموازي، ولم يرد أن يتراجع الآن، خاصةً وأنّه لم يتحمل أي خسائر تذكر حتّى اللحظة. لقد تغاضى الغرب عنه في سوريا إلى درجة التشجيع، حتى مع ارتكاب قواته كل تلك الجرائم البشعة. إذن الثمن كان صغيراً وقد يرى أنّ الغرب يتراجع تحت ضرباته الآن، ولم يعد أحد يستطيع فرض شيءٍ عليه بعد اللحظة. لقد أباد مدناً وقرى بكاملها ولم يتحرك أحد.
امتلك الطور السوري في العدوان الروسي عدّة تحولات لمشوار بوتين نحو استكمال إمبراطوريته المزيفة، إذ كان على موسكو تقديم رواية تستطيع التماسك لدعم عملياتها العسكرية وقصفها الجوي في سوريا، وهو ما ساهم إلى حد كبير في زيادة العمل وتنشيط أذرع البروباغندا الروسية حول العالم؛ على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر قنوات مجانية ناطقة بعشرات اللغات حول العالم، ومن خلال شخصيات مشهورة ومغنين معروفين عالمياً. ضخٌّ هائل للمعلومات المضللة وأنصاف الحقائق والأكاذيب بشكل منظم ليعمل على تشويه أي حقيقة يمكن أن يخرج بها المتابع العادي حول العالم حول ما يجري في سوريا.
أصبح لكل حدث كبير رواية مضادة روسية، فجرائم ارتكبت باستخدام السلاح الكيميائي أصبحت فبركات من عمل منظمات مدنية سورية معارضة، ومذابح ومقاطع فيديو توثقها أصبحت إما ملفقة أو من زمان آخر ومكان آخر، وتقارير صادرة عن جهات دولية عالية المصداقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو عن مسؤولية النظام السوري عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين تصبح تقارير سياسية أو مسيسة أو متلاعب بها.
لم يقتصر الأمر في الدعاية الروسية على مجرد التشكيك وخلق رواية إعلامية أخرى على دأبِ إعلام النظام السوري بطريقة غير متقنة. بل من خلال عمليات استخباراتية لإرهاب وتخويف الشهود من الناجين، ومن خلال تلفيق أدلة وخلق بلبلة حول كل حادثة؛ مثل تسريب ويكيليكس لمراسلات شخصيات ادعت أنها شاركت في التحقيق حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا تنتقد التقرير النهائي، لنكتشف لاحقاً بأنهم مجرد شخصين لم يشاركوا في أي مراحل مهمة من العملية ولم يستمروا حتى النهاية فيها. هذا مثال من أمثلة كثيرة على عمليات تضليل منظمة واسعة النطاق تستهدف التشكيك بما يجري في سوريا لتصبح جرائم الحرب غير أكيدة وتصبح الحرب على المدنيين واقتلاعهم مجرد نزاع معقد لا يمكن فهمه.
هذا التناغم بين رواية رسمية روسية تدعي محاربة الإرهاب في سوريا، وهو ما يراد به أن تكون موسكو نظيرة للولايات المتحدة خلال الحلقات الأخيرة من حرب واشنطن على الإرهاب، وبين عمليات التضليل المنظمة التي قادتها شبكات موسكو العلنية وغير العلنية، وفر غطاءً جيداً جداً لتلك الجرائم التي كانت موسكو من خلالها تقوم بأمرٍ آخر، وهو استعادة سمعة أسلحتها عالمياً في أسواق العالم الثالث.
أصبحت وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديوهات لعمليات القصف التي تنفذها بمختلف الأسلحة لا من أجل تغطية عملياتها المزعومة ضد المنظمات الإرهابية، بل بهدف إظهار مدى دقتها وتطورها. كانت فيديوهات صواريخ اسكندر وهي تستهدف المدنيين في سوريا مجرد مقاطع إعلانية للصناعة العسكرية الروسية، التي أشارت بيانات تصدير الأسلحة بأنّها استفادت بالفعل من تلك العمليات كترويج لها، وإن لا يمكن تحديد مدى تلك الاستفادة بمعزل عن ارتفاع منسوب التوتر في عدة مناطق في العالم، ما يؤدي إلى زيادة مبيعات الأسلحة بمعزل عن العوامل الأخرى.
وفي مقابل كل تلك الانتهاكات، لم يحصل أن واجهت موسكو أو بوتين أي مشاكل حقيقية. في الواقع الذي حصل هو أن الدول الغربية رفعت من وزن الدور الروسي في سوريا على الفور، وتفاعلت معه كأمر واقع مباشرةً، متقبلةً ذلك الحضور، ولم تتوانَ عن التصريح بأنّها لا تريد توجيه أي تهديد حقيقي له في المستقبل القريب أو البعيد. كان بوتين والأوليغارشيون من حوله مثل يفغيني بريغوجين يحصلون على العقود الاقتصادية لاستثمار ما تبقى من موارد في سوريا وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد بين حكومة النظام السوري وروسيا، تثبت وجود قواعد بحرية وجوية روسية في سوريا وتعطيها حقوق استثمار وإدارة الموانئ السورية في المتوسط.
هو تمادٍ غير مسبوق لروسيا خارج أراضيها، لم يكن ممكناً قبل سنوات قليلة. الآن بوتين أصبح لاعباً شديد الأهمية في منطقة ما من العالم وإن كانت على هامش الاهتمامات الدولية. كل ذلك لا بدّ بأنّه أوحى لفلاديمير بوتين بأنّ عالمه الموازي يمكن أن يتسع لامبراطوريته حقّاً، امبراطورية يجب كما يرى أن تضمّ -أولاً- كل الأراضي التي خسرها الاتحاد السوفييتي، وبهذا كان من الصعب على الرجل أن يتخيل ردّة فعل غير التي عهدها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. كانت سوريا العتبة الفاصلة قبل تخطيطه لغزو كييف.
المرحلة قبل الأخيرة: مرحلة الوحش
كل ذلك سيقودنا إلى الأسابيع الماضية، بعد أشهر من دخول الأوضاع في سوريا إلى حالة من السكون العسكري التي لم تعد تعطي بوتين جرعة العظمة الكافية لاستمرار عالمه الموازي، فكانت أوكرانيا على موعد مع تحركات عسكرية واسعة قامت بها القوات الروسية على الجبهات مع شرق أوكرانيا، وحتى مع شمالها في الأراضي البيلاروسية تحت حجة القيام بمناورات مشتركة يبدو أن الرئيس البيلاروسي أجبر على الموافقة عليها، وذلك بعد أن ضمن بوتين بأنّ ذلك الرئيس الذي كادت المظاهرات في بلاده أن تطيح به قد أصبح كما يحب بوتين؛ رئيساً دمية أو جندياً على خريطة المعركة التي ينصبها فلاديمير في عالمه الخاص.
وعلى الرغم من التصريحات الأميركية التي أذاعت تقارير استخباراتية عن نية بوتين القيام باجتياحٍ عسكريٍ واسع لأوكرانيا، كانت معظم التحليلات تقود نحو عمليات محدودة كالتي جرت في عامي 2008 و2014 لشرق أوكرانيا. ساعد في ذلك التضليل الروسي المستمر حول عدم وجود نيّة للغزو، والتصريحات عن سحب أجزاء من القوات العسكرية من الحدود مع أوكرانيا، قبل أن تبدأ بالفعل عملية الاجتياح التي لم تشمل محاور في شرق وجنوب شرق أوكرانيا فقط، بل حدودها الشمالية مع بيلاروسيا الأقرب للعاصمة كييف أيضاً، حيث بدا في الـ48 ساعة الأولى أنّ الجيش الأوكراني قد انهار أو تراجع تماماً أمام الضربات الروسية، وبأنّ دخول الروس إلى كييف أصبح مسألة وقت، هذا إن لم يكن قد حصل فعلاً بسبب تضارب الأنباء من خطوط القتال هناك، ولتسقط ثاني أكبر المدن الأوكرانية خاركيف شرق البلاد بيد موسكو.
يمكنك تخيل بوتين يجلس في غرفة كبيرة تحتوي مكتباً كبيراً وبسقفٍ مبالغ في ارتفاعه، يستمع لموسيقى المارش السلافي التي ألفها بيتر تشايكوفسكي في القرن التاسع عشر لتكون نشيداً للجنود الروس والصرب في معاركهم آنذاك مع الإمبراطورية العثمانية؛ شيءٌ شبيه باستلهام هتلر لموسيقى Ride of the Valkyries، وهي قطعة من أوبرا للمؤلف ريتشارد فاغنر حاول فيها استدعاء الروح القومية الألمانية في القرن التاسع عشر أيضاً.
يضع تلك الموسيقى على مكبرات ضخمة للصوت، وينظر مستنداً على يديه إلى خريطة على شاشة الكمبيوتر أو في خياله -لا فرق- إلى امبراطوريته وهي تكبر وتتسع، فلا أحد يستطيع إيقافه الآن. يأمر وزير الدفاع ورئيس الأركان بوضع القوات النووية في حالة التأهب القصوى مهدداً العالم أجمع بما يملكه من تركة الإمبراطورية السوفيتية للحصول على ما يراه حقّاً لروسيا تخلى عنه لينين وستالين وخروتشوف.
48 ساعة من التورط الروسي في عمليات غزو شاملة لجارته الأصغر أوكرانيا، كانت كافية لنرى أنّ هذه الإمبراطورية أو القوّة العظمى ليست موجودة بالفعل في عالمنا، إذ أكدّت تقارير صحفية تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بأنّ جيش بلادهم استطاع استعادة خاركيف بعد معارك شوارع مع القوات الروسية الغازية، فيما لم تستطع موسكو دخول كييف التي كانت قد وصلت حدودها بعد ساعاتٍ من بدء الغزو، ويبدو الموقف الغربي الحاسم جداً لمعارضة اعتداءات بوتين هذه المرة سيكلفه الكثير من الخسائر.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دوله أسلحةً لأوكرانيا، بما في ذلك طائرات مقاتلة في صفقات ممولة من الاتحاد الأوروبي نفسه، الألمان للمرة الأولى يتخذون قراراً حاسماً بإيقاف مشروع أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» والولايات المتحدة تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما الجميع يفرض عقوبات اقتصادية شديدة القسوة على روسيا، أخرجتها، جزئياً حتى الآن، من نظام تحويل SWIFT، وهو أكبر نظام دولي لإرسال واستقبال التحويلات النقدية بين البنوك في العالم. هذا إلى جانب العديد من الإجراءات التي قد تمتلك أثراً معنوياً، مثل إلغاء أحداث رياضية في موسكو ومنع عزف النشيد الروسي في مباريات كرة القدم، أو منع الطائرات المدنية الروسية من الطيران في الأجواء الأوروبية. يجد بوتين نفسه معزولاً تماماً هذه المرة ليس في عالمه الافتراضي منتصراً وحيداً، لكن في العالم الحقيقي يدفع أثمان ربما لم يتوقعها بعد كل التغاضي الغربي عنه طوال سنوات. لم يكن ليتوقع ذلك بالتأكيد، فما جرى في سوريا كان يشجعه على ذلك، حيث لم يهتم أحد بكل هؤلاء الضحايا، بمدنهم وبلادهم التي دمّرت، أو بتهجيرهم من دون أمل في العودة. ما الذي سيتغير في حالة أوكرانيا؟
من كتيب الثامن عشر من برومير الذي نشر أولاً كمقالة في مجلة الثورة الألمانية الصادرة من نيويورك عام 1852، اقتبس الكثير من الكتّاب جملة ماركس الشهيرة «التاريخ يعيد نفسه أولاً كمأساة، ومن ثمّ كملهاة سخيفة». بطريقة ما تدبر بوتين أمره هذه المرة أيضاً بأن يجمع المأساة والكوميديا السخيفة في استعادته للتاريخ في عالمه الموازي، والذي «تثقله تقاليد كل الأجيال الميتة ككابوس».
موقع الجمهورية
————————–
غزو أوكرانيا: بوتين النووي في مواجهة الديموقراطية/ إيلي عبدو
بوتين، كشف عن نزوع غير عقلاني بعد تهديده بالنووي، وهذا سلوك لا يستقيم مع صانع استراتيجيات وخطط تتعلق بالثروات والتراكيب السكانية، بقدر ما ينطبق على دكتاتور يطمح لأن يكون توتاليتاريا، فيما الروس ضحاياه الأكثر تضرراً.
ليست الديموقراطية في أحسن حالاتها في الغرب.
صعود اليمين الشعبوي بموازاة سوء الأوضاع الاقتصادية، وتجربة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السلبية مع المؤسسات في أميركا، والأسئلة التي طرحتها إجراءات “كورونا”، كلها مؤشرات، إلى مشكلة تتبلور أكثر وأكثر داخل الدول الغربية. لكن انعكاس هذه المشكلة يتبدى بشكل آخر على عدد من المثقفين والمحللين العرب، إذ إن هؤلاء لا يبنون مقاربتهم على أسباب ضعف الديموقراطية، قياساً بشرط الداخل الغربي فقط، وإنما بتعامل الحكومات الغربية مع الشرق الأوسط، و”تهاونها” مع المستبدين فيه، وقبولها التعامل معهم. فتكمل بالنتيجة، صورة تسفيه الديموقراطية، وعزلها عن أي صراع أو صدام، فالغرب يعاني في ديموقراطيته، ويتجاهل معاناتنا مع “مستبدينا”، ويضع يده بيدهم.
وعليه، الديموقراطية بلا معنى، وجميع القوى متشابهة والمصالح هي الأساس. هذا التحليل برز بشكل لافت، عند مقاربة الغزو الروسي البوتيني لأوكرانيا، وتحكّم بالكثير من المواقف، التي تسابق أصحابها للحديث عن الغاز ومخاوف موسكو من انضمام كييف إلى حلف الناتو، والتاريخ المشترك بين البلدين وتداخل التراكيب السكانية، في تغييب متعمد لطبيعة النظام الغازي وطبيعة الدولة التي تتعرض للغزو، واقتراب كل منهما من تطبيق الديموقراطية، وابتعاده منها.
أصحاب هذا التحليل، يتجاهلون أن الديموقراطية في الغرب ليست قيمة مجردة أو معزولة، بل هي مرتبطة بالشرط السياسي والاقتصادي، فصعود اليمين وتراجع الاقتصاد، قد يضعفانها، وتقدم الوسطيين والليبراليين، وازدهار الاقتصاد يجعلانها أقوى. ويتجاهلون أيضاً أن الديموقراطية لا تحل المشكلات بقدر ما تسمح بتظهيرها وإدارتها ضمن تسويات ومن دون عنف. في أذهان هؤلاء، الديموقراطية، ليست ديناميكيات تتأثر ببنى، هي تجريد شعاراتي، يشبه ذلك الذي درج مع بداية الربيع العربي، حين راحت النخب تتحدث عن ضرورة الديموقراطية، من دون ربطها بأوضاع الجماعات وحساسياتها.
مسألة الهوية التي يبيعها الرئيس الروسي لشعبه، لا يمكن مقاربتها بمعزل عن الديمقراطية، إذ يستخدمها بوتين ضمن عدته، ولا تتطور بشكل طبيعي مثلما يمكن أن يحدث في أوكرانيا .
الفهم الثابت، للديموقراطية، يمكن أن يساعد، على فهم النقد الذي نوجهه للغرب في التعامل مع النظم الديكتاتورية في منطقتنا، فهو يوازن بين مصالحه وقيمه، وتتفاوت مواقفه تبعاً لهوية من يحكم وظروفه، إلى عوامل أخرى. هذا، ليس لتبرير مواقف مدانة، بطبيعة الحال، طالما أنها، تتهاون مع المستبدين، لكنها محاولة لربط هذه المواقف مع ديناميكيات الداخل الغربي وتفاعلاته، والتي، تؤثر أيضاً في الديموقراطية، قوة وضعفاً. وبالنتيجة، تغييب مسألة الديموقراطية انطلاقاً من ضعف هذه القيمة في الغرب، مبني على فهم مغلوط، واستنتاجات متسرعة، تفصل الديموقراطية عن الشرطين السياسي والاقتصادي، وتحيل الغرب إلى مبشر دائم بها.
لكن حتى ثنائية ديمقراطية – دكتاتورية، تحتاج لتطوير لمقاربة مجدية للغزو الروسي لأوكرانيا. فالأخيرة، ليست دولة ناجزة ديمقراطياً، مسارها الفعلي بهذا الشأن بدأ عام 2014، في الوقت نفسه روسيا البوتينية ليست دكتاتورية كلاسيكية، هي دكتاتورية توسعية معطوفة على نزوع إمبراطوري متخيل، تستخدم مرتزقة هنا وهناك، وتشن هجمات الكترونية وتتدخل في مصائر الانتخابات في عدة دول.
دكتاتورية بوتين تجنح نحو التوتاليتارية دون أن تكونها بالضرورة. شبه توتاليتارية تستفيد من التكنولوجيا ومواقع التواصل للتضليل والتأثير على الرأي العام الغربي، وكذلك من أسواق المال عبر زرع شركات في بورصات الغرب تخدم مصالح الكرملين. نظام بوتين يتغذى من عناصر حديثة، دون أن يتخلى أن عناصر توتاليتارية كلاسيكية تتعلق بقضم بلدان مجاورة. من هنا، فإن غزو بوتين لأوكرانيا مرتبط بطبيعة نظامه، أكثر مما هو مرتبط بالتحليلات الإستراتيجية التي انتشرت بكثافة في الصحف، خلال الأيام الماضية.
الأرجح أن المسألة معكوسة، بمعنى، أن التحليل الاستراتيجي بكل عناصره، يمكن أن يدرج ضمن أجندة بوتين شبه التوتاليتارية، الغاز والثروات لتمويل مشاريع التوسع، والتناقضات والاختلافات المتعلقة بالسكان، ذرائع للتدخل، والخوف من “الناتو”، عائق أمام المشروع الإمبراطوري. وكل ذلك، لحرف الانتباه عن مشاكل الداخل وإقناع الروس بأوهام تاريخية، على حساب حريتهم وازدهارهم الاقتصادي، تمهيداً لفضلهم عن واقعهم الموضوعي وخلق واقع مواز مبني على صناعة الكذب البوتينية.
مسألة الهوية التي يبيعها الرئيس الروسي لشعبه، لا يمكن مقاربتها بمعزل عن الديمقراطية، إذ يستخدمها بوتين ضمن عدته، ولا تتطور بشكل طبيعي مثلما يمكن أن يحدث في أوكرانيا التي يتحسر الممانعين العرب على وجود قوميين فيها، هؤلاء القوميون يمكن أن تستوعبهم الديمقراطية الوليدة ومؤسساتها وتخفف تطرفهم، عكس الهوية في روسيا التي يتحكم فيها طموح بوتين السلطوي.
أسبقية عنصر الديمقراطية على التحليلات الاستراتيجية، تكشفت بوضوح أكثر، مع متابعة مقاومة الأوكرانيين لغزو بلادهم، إذ دافع أهالي كييف ومدن أخرى عن أنفسهم ضد التحليلات التي تسعى لتغييبهم، دافعوا عن حقهم بالأوربة وبتجربة الديمقراطية الوليدة التي حاول كثر تسخيفها.
في المقابل. تبدت التحليلات الاستراتيجية ، أقل معنى، خصوصا وأن بوتين، كشف عن نزوع غير عقلاني بعد تهديده بالنووي، وهذا سلوك لا يستقيم مع صانع استراتيجيات وخطط تتعلق بالثروات والتراكيب السكانية، بقدر ما ينطبق على دكتاتور يطمح لأن يكون توتاليتاريا، فيما الروس ضحاياه الأكثر تضرراً.
—————————

«تجارب» روسيا والغرب في «المختبر السوري»… هل تتكرر في أوكرانيا؟/ إبراهيم حميدي
هل هناك دروس في «سلوك» روسيا العسكري والسياسي والإنساني في سوريا يمكن الاستفادة منها، في فهم مغامراتها الجديدة بأوكرانيا؟ وهل يمكن أن تقوم موسكو بنسخ «السيناريو السوري» في الحرب التي تخوضها على الحدود الروسية الغربية؟ أيضاً، ما تقاطعات التجارب الغربية بين «الملفين»؟
«الأرض المحروقة»
في نهاية 2016، حذر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون (رئيس الوزراء الحالي) ونظيره الأميركي السابق جون كيري، موسكو من تحويل مدينة حلب إلى «غروزني سوريا»، في تشبيه مع عاصمة الشيشان التي اعتبرتها الأمم المتحدة في 2003 «المدينة الأكثر دماراً على وجه الأرض» بعد محاصرة قوات روسية ولها وتدميرها. وردت السفارة الروسية في واشنطن على موقع «تويتر» بالقول: «غروزني اليوم هي مدينة سلمية وحديثة ومزدهرة. أليس هذا الحل الذي نبحث عنه جميعاً؟».
كان هذا الأمر نموذجاً لفهم روسيا في تدخلها العسكري بسوريا نهاية 2015 لـ«إنقاذ الدولة السورية». وفي نهاية العام الماضي، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن جيشه «جرّب» في سوريا 320 طرازاً من مختلف الأسلحة، الأمر الذي استمر إلى هذه الأيام، حيث جرى نشر طائرات «ميغ 31 كا» قادرة على حمل صواريخ «كينغال» بقاعدة حميميم غرب سوريا. و«كينغال» صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته 10 أمثال سرعة الصوت، ويتبع مساراً متعرجاً، وهو ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ، وكان بين الأسلحة التي شاركت في المناورات البحرية قبالة ساحل سوريا عشية الهجوم على أوكرانيا.
وحسب خبراء عسكريين، فإن القوات الروسية اتبعت سياسة «الأرض المحروقة» في دعم قوات دمشق، التي رفعت حجم الرقعة التي تسيطر عليها من 10 في المائة إلى 65 في المائة. وغالباً ما كانت تأخذ قرية، مثل اللطامنة في حماة وحمورية في غوطة دمشق واللجاة في ريف درعا، «نموذجاً» لإيصال «إنذارات نارية» وإخضاع مناطق المعارضة بعد حملة عنيفة من القصف الجوي من قاذفات جوية و«براميل» وطائرات «درون» انتحارية.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل 21 ألف شخص في غارات جوية روسية، خلال 77 شهراً من التدخل العسكري، من أصل نحو نصف مليون سوري قتلوا خلال عقد من الصراع. وتحدثت الأمم المتحدة عن استخدام غازات سامة وأسلحة كيماوية خلال المعارك.
موسكو تدخلت في سوريا لصالح «الجيش الحكومي» وكانت تواجه فصائل معارضة مختلفة المشارب والإمكانات والدعم، بينها فصائل إسلامية بعضها متشدد أو تابع لـ«القاعدة» و«داعش»، فيما هي في أوكرانيا تقاتل جيشاً نظامياً في دولة هائلة مجاورة وتنتمي إلى التاريخ نفسه. إلى الآن، لا يبدو أن التكتيتات العسكرية ذاتها في «المعركتين»، حيث لا يزال يغيب القصف العشوائي و«الأرض المحروقة» و«البراميل» والغارات الجوية العنيفة. لا شك أن هذا سيخضع للاختبار في الأيام المقبلة، بعد إغلاق موسكو الأجواء الأوكرانية وتصاعد العمليات ومقاومة أصحاب الأرض.
«انسحابات إعلامية»
أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها بصدد «تخفيف» عملياتها العسكرية في سوريا أو سحب بعض قواتها، ونشرت أكثر من اتهامات عن نية «الخوذ البيضاء» التحضير لـ«مسرحية كيماوية» بهدف «اتهام الحكومة السورية بها». كان هذا يحصل قبل بدء هجوم عسكري شامل أو جولة تفاوضية سياسية في جنيف.
وأعلنت وزارة الدفاع عدم اعترافها بـ«شرعية» فصائل مقاتلة «معتدلة»، بينها «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» في بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، تمهيداً للانقضاض عليها وقصف مقراتها، لأنها «مرتبطة بالإرهاب». ووقعت موسكو سلسلة اتفاقات و«تسويات» بتعاون مع واشنطن أو مع «ضامني» عملية آستانة الآخرين، أنقرة وطهران، لكن سرعان ما كانت تنقلب على الاتفاقات مع مرور الوقت وتغير المعطيات. وآخر مثال على ذلك، «تسويات» درعا التي أنجزت في 2018، وبقيت صامدة إلى العام الماضي، حيث جرى الانقلاب عليها.
التجربة الأوكرانية مختلفة، لكن الآن، هناك بعض التقاطعات المشتركة. موسكو أعلنت سحب قواتها من حدودها الغربية، قبل الشروع عملياً في الغزو الشامل. وأعلنت أنها تريد المفاوضات، قبل جولة جديدة من التصعيد. وزارة الخارجية، تلعب دور «المدافع» و«الدبلوماسي» في المعركة التي تخاض عملياً من قبل وزارة الدفاع بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. هناك هدف عسكري معروف، في سوريا كان «استعادة سيطرة الدولة» و«دعم القوات الحكومية»، قد يتم التريث أو التكيف لتنفيذه. العقبات الوحيدة أمامه هي عسكرية وليست سياسية، والمفاوضات ما هي إلا أداة لتنفيذه وشراء الوقت للوصول إليه.
وأعلنت موسكو أكثر من مرة فتح «ممرات إنسانية» لخروج الناس من «هيمنة الإرهابيين»، قبل أي معركة.
ورعت كثيراً من المقايضات لـ«هندسة اجتماعية» ونقل ناس من مكان إلى آخر، من الجنوب إلى الشمال تحديداً. ولم توقف هجرة 13 مليوناً من النازحين واللاجئين.
وليس مستبعداً أن تترك موسكو الباب مفتوحاً أمام هجرة أوكرانيين إلى الجوار، ما يسمح أيضاً بلعب «ورقة الهجرة» في أوروبا من جهة، والوصول إلى «مجتمع منسجم» في أوكرانيا من جهة ثانية. والمستقبل، سيقرر ما إذا كانت موسكو وواشنطن ستعملان معاً، أم لا، في ملفات إنسانية، مثل رعاية قرار دولي لتقديم مساعدات «عبر الحدود»، كما حصل في سوريا، من دون مظلة جوية.
«برنامج سري»
الدروس المستفادة ليست روسية وحسب، بل هناك إمكانية لاختبار تجارب دول أخرى في «المختبر السوري»، ولعل أبرزها «العسكرة» و«القوة الصلبة». إذ إنه في نهاية 2012 وبداية العام اللاحق، رعت «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي إيه) الأميركية برنامجاً سرياً لتدريب فصائل معارضة ورصدت لهذا البرنامج مليارات الدولارات، ما أسهم في تراجع قوات النظام إلى أبواب دمشق قبل التدخل الروسي. وخلال كل فترة التدخل، رفضت أميركا إقامة منطقة حظر جوي جنوب سوريا وشمالها، لكنها سرعان ما أقامت مع التحالف الدولي ضد «داعش» منطقة حظر في شمال شرقي البلاد منذ 2014، لهزيمة التنظيم ومنع عودته. في موازاة ذلك، استخدمت تركيا أيضاً قواتها البرية والجوية بموجب الذهاب إلى «حافة الهاوية» ضد قوات دمشق من جهة، وتفاهمات ثنائية واستراتيجية مع روسيا من جهة ثانية.
التجربتان الأميركية والتركية، تقومان على مبدأين: تدريب فصائل سورية وإمدادها بالسلاح عبر الحدود والدعم الجوي، وعقد تفاهمات وترتيبات مع روسيا لمنع الصدام العسكري على الأرض السورية، للوصول إلى «مناطق نفوذ» بين اللاعبين الخارجيين.
وتجري حالياً اتصالات بين أجهزة استخبارات غربية للإفادة من «التجربة السورية» في أوكرانيا.
معروف أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا ودولاً أخرى، قررت إرسال أسلحة إلى كييف لدعم الجيش الحكومي. لكن السؤال: كيف يتم إيصالها إلى داخل أوكرانيا وجيشها؟ أحد السيناريوهات التي تتم دراستها، هو تأسيس برنامج سري بحيث يتم إيصال السلاح عبر حدود بولندا، في وقت تصعّد روسيا هجماتها غرب كييف، لقطع خطوط الإمداد و«تقطيع أوصال» أوكرانيا خصوصاً الأجزاء الغربية، لإغلاق الأبواب أمام الخطط الغربية. كيف سيتم ذلك من دون حصول مواجهة بين روسيا و«حلف شمال الأطلسي» (الناتو)؟ هل يؤدي هذا إلى تفاهمات ومقايضات ومناطق نفوذ في أوكرانيا كما الحال في سوريا؟
الشرق الأوسط
——————————-
“الأيقونة والفأس”: أوكرانيا جزء من إمبراطورية بوتين المتخيلة/ محمد خلف
موسكو تواصل الابتزاز، والتمعن في خطاب بوتين يعيدنا إلى تسعينات القرن الماضي عندما شن الديكتاتور صدام حسين الحرب على الكويت، مستخدماً العبارات المتشددة والعنجهية.
في أوائل عام 1994، وبعد 4 سنوات من انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، وصف مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق زبيغنيو بريجنسكي أوكرانيا القوية والمستقرة بأنها ثقل موازن حاسم لروسيا.
وقال في تنبيه للغرب إنها ينبغي أن تكون محور اهتمام وتركيز الإستراتيجية الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة، فإذا سيطرت روسيا على أوكرانيا فيمكنها أن تعيد بناء إمبراطوريتها من جديد.
اليوم يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا بمثابة سكين في يد الغرب والولايات المتحدة لاحتواء دولة روسيا وطموحاتها الكبرى.
حذر برجينسكي بعد انتهاء الحرب الباردة من إذلال روسيا، ومن هنا لم يكن من المستغرب أن يقول له ديبلوماسي روسي يعمل في سفارة بلاده في واشنطن ذات يوم، “المعضلة الحقيقية في علاقتنا بالولايات المتحدة محورها اعتقادهم أن الحرب الباردة انتهت بانتصارهم وهزيمتنا، لذا يتبنون سلوك المنتصر ويتوقعون منا سلوك المنهزم”. أضاف الديبلوماسي: “نحن نرى أن الحرب الباردة انتهت دون إطلاق نار، ودون منتصر ولا مهزوم”، وهذا هو جوهر الخلافات بين موسكو وواشنطن في الكثير من القضايا العالمية، وعلى رأسها مصير أوكرانيا، الدولة المجاورة لروسيا والتي لا يعرف معظم الأميركيين موقعها على الخريطة.
كان بالإمكان برأي البروفيسور ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، بالمرونة والتفاوض الإيجابي تجنب هذه الازمة بأكملها لو لم تستسلم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون للغطرسة والتمني والمثالية الليبرالية، ولو اعتمدوا بدلاً من ذلك على الرؤى الأساسية للواقعية. والواقع أن روسيا ربما لم تكن لتستولي على شبه جزيرة القرم، وأن أوكرانيا سوف تكون أكثر أماناً اليوم، لو اتبعت واشنطن سياسات مغايرة في حقبة ما بعد الحرب الباردة. وأشار والت إلى أنه لو كان صناع السياسة الأميركيين قد فكروا في تاريخ بلادهم وحساسيتها الجغرافية، لكانوا فهموا كيف بدا توسيع حلف شمال الأطلسي لنظرائهم الروس.
بوتين وامبراطورية الأكاذيب
منذ بدء الحرب ضد أوكرانيا، ركزت التحليلات على ما يحدث بالضبط هناك على الأرض. ومع ذلك، لفهم ما قد يحدث الان وفي المستقبل وماهية أهداف الرئيس بوتين بالضبط، ينبغي أن نقرأ بعناية خطابه إلى مواطني روسيا.
بهذه الطريقة فقط يمكننا فهم السياق العام لما يحدث في أوكرانيا.
يعرّف الرئيس بوتين الولايات المتحدة على أنها عدو ويسميها “إمبراطورية الأكاذيب”، وحلف الناتو ليس إلا “مجرد أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية”. “تلك القوات التي قامت بانقلاب عسكري. في أوكرانيا عام 2014 استولت على السلطة واحتفظت بها من خلال إجراءات انتخابية مزورة”. وبحسب الرئيس الروسي، “أوكرانيا دولة قومية متطرفة ونازية جديدة”. لذلك، بعد تحديد صورة العدو- الناتو وصف السلطة الأوكرانية المنتخبة ديموقراطياً والموالية للغرب، بأنها استولت على السلطة، من خلال انقلاب قام به القوميون المتطرفون والنازيون الجدد بدعم من الغرب”.
هذه الكلمات عكست بشكل واضح أهداف الحرب التي أعلنها على أوكرانيا الرئيس الروسي وهي: أولاً “توفير الحماية للمواطنين الذين تعرضوا لمدة 8 سنوات لقمع وحشي وإبادة جماعية من قبل نظام كييف”. “هذا هو السبب في أننا سنسعى جاهدين لنزع السلاح واجتثاث النظام من أوكرانيا”.
احلام اجتثاث أوكرانيا وإزالتها من الخارطة الأوروبية
الجملة الأخيرة هي التي يجب أن تلفت انتباه جميع القادة والمحللين السياسيين في الغرب والعالم تتمثل في فكر القيصر الروسي وهي أن ما يحدث ليس عملاً عسكرياً محدوداً على أراضي دونباس، بل يتعلق بغزو أوكرانيا بأكملها. وأوضح بوتين، “في الأشهر الأولى، فقدنا مناطق ضخمة ومهمة استراتيجياً وخسرنا ملايين الضحايا. لهذا فإننا لن نرتكب مثل هذا الخطأ مرة ثانية، ليس لدينا مثل هذا الحق”.
ليس هناك أدنى شك بأن بوتين يجري تشبيهاً غير مناسب تماماً بين أوكرانيا وألمانيا النازية، كما أن خططه لا تقتصر على ما يسمى جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين، ولكن أيضاً بشعب أوكرانيا بأكمله، الذي قال إنه “وقع تحت نير الحكومة التي استولت على السلطة بانقلاب دموي، بالتواطؤ مع القوميين المتطرفين والنازيين الجدد.
ليس هذا فقط فلقد خاطب الرئيس الروسي في كلمته جنود القوات المسلحة الأوكرانية قائلاً: “لقد أقسمتم الولاء للشعب الأوكراني، وليس للسلطة الحاكمة التي لا تتوقف عن نهب ثروات البلاد، وتمارس الابادة ضد الشعب”، داعياً الجنود والضباط إلى عدم طاعة أوامرها الإجرامية، على حد تعبيره.
لنضع جانباً هذه العقلية النرجسية والعنجهية في الحديث عن خيارات الدول والشعوب الأخرى، وتحديد ما يضرهم وما يفيدهم، فإن ما يبعث فعلاً على القلق الصدمة، هو وقاحة بوتين بحديثه ومطالبته الجيش بتسليم أسلحته واجتثاث الدولة الاوكرانية بأكملها، أي محوها من الخارطة.
قامت السردية الروسية (البوتينية) على الاصح حتى الان على حماية السكان الروس في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من الكرملين. انصب اهتمام المراقبين و المحللين طيلة الأسابيع المنصرمة للبحث عن إجابات عما إذا كانت القوات الروسية ستدخل فقط إلى لوهانسك ودونيتسك أو إذا ما كانت ما ستنطلق في حرب فعلية للسيطرة على مناطق اخرى بأكملها أكبر بكثير من هاتين الجمهوريتين اللتان اعترفت بهما روسيا. الواقع أن عدد الروس في المناطق الشرقية والذين منحهم بوتين الجنسية الروسية لا يزيد على 800 ألف من أصل 4 ملايين أوكراني يعيشون منذ عقود طويلة في هذه الأقاليم. لقد أثار بوتين في خطابه قبل شن عدوانه الإجرامي أسئلة اكثر بكثير مما كنا نطرحه حتى الآن، ويرافقها قلق أكبر بكثير.
مع الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية في روسيا، يتغير الوضع في الأزمة الأوكرانية بشكل كبير. إن النزاع وما أفرزه من أوضاع استمرت مجمدة منذ 8 سنوات أصبح من الماضي والتاريخ، بعدما أعلنت روسيا رسمياً سيطرتها عليها باعترافها باستقلال المنطقة وإبرامها الاتفاقيات مع القادة الانفصاليين الذين يحكمون عملياً هذه الأقاليم خارج القانون والدولة الاوكرانية. وما يسمى باتفاقيات مينسك وعملية نورماندي أصبحتا في سلة المهملات. هذا يعني إعادة رسم حدود جديدة في أوروبا في انتهاك صارخ للقانون الدولي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
جنون القيصر وتصحيح التاريخ
يعي الغرب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث الآن عن عذر للحرب من خلال شن هجوم أوكراني (على غرار نزاع 2008 مع جورجيا) على القوات الروسية. المحادثات الديبلوماسية، التي كانت حتى الآن محادثات بين الصم، هي مجرد مسألة وقت على الجانبين.
موسكو تواصل الابتزاز، والتمعن في خطاب بوتين يعيدنا إلى تسعينات القرن الماضي عندما شن الديكتاتور صدام حسين الحرب على الكويت، مستخدماً العبارات المتشددة والعنجهية، ووصف كما يفعل بوتين الآن الكويت بأنها “دولة مصطنعة”، وما أعقب ذلك من دمار وانهيارات سياسية ومجتمعية واقتصادية لم يخرج منها العراق حتى الآن.
أفكار بوتين الآن وتحليله التاريخي لأخطاء لينين وستالين وخروتشوف في منح أوكرانيا الاستقلال وفصلها عن الممتلكات الروسية الأصلية تبدو استنساخاً لرؤية صدام، ما يثير القلق حول مآلات هذه الحرب ونتائجها المجهولة. بوتين وقبله صدام أظهرا نية صريحة وصادمة لمراجعة التاريخ وتصحيحه، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو “إلى أين يمكن أن يذهب بوتين في حربه على أوكرانيا، التي هي في الواقع حرب على أوروبا برسائل إلى الولايات المتحدة؟”.
بوتين كما يظهر من خطاباته اختار تكتيك تصعيد التوترات بشكل مطرد وإيصالها إلى نقطة تفرض “يالطا” أو “مالطا” جديدة، أي الحديث عن نظام أمني جديد وتوازن جديد في أوروبا والعالم. ولكن ما استطاع تحقيقه حتى الآن هو عقوبات جديدة مدمرة وعزلة دولية شاملة.
يُظهر الرئيس بوتين كل أعراض جنون القيصر، بحسب عالم النفس إيان روبرتسون، الذي توقع أن رئيس الكرملين لن يتوقف عند التهديدات فحسب، بل سيهاجم اوكرانيا ويشن حرباً كارثية ربما تتعدى هذه الدولة إذا لم يتم إيقافه.
تختلف التقديرات الغربية في الحكم على شخصية بوتين واستجلاء ما يدور في عقله؛ بين من يراه لاعب شطرنج ماهراً على رقعة الخريطة الجيوسياسية العالمية، ومن يراه إنساناً مغامراً يخوض خطوات غير محسوبة العواقب.
يميز البروفيسور جيلبرت الأشقر، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية “سواس” (SOAS)، بين نظرتين مختلفتين يحملهما الغرب عن بوتين: الأولى قبل الأزمة الأوكرانية، وتقول إن بوتين “شخص عدواني لكنه عقلاني”، أما النظرة الثانية “فهي أن الأزمة الأوكرانية أظهرت أن عدوانية بوتين غلبت على عقلانيته”.
يعود البروفسور جيلبرت إلى المقالات والخطب التي ألقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليصل إلى أنه “بات مهووساً بإعادة أمجاد روسيا القيصرية، ولهذا نجده يوجّه انتقادات لاذعة للثورة البلشفية؛ لأنها هي التي أنهت روسيا القيصرية، والآن يعيش هوس أن يصبح قيصر روسيا الجديد”.
ما هو جنون قيصر؟
بدأ تداول مصطلح “جنون القيصر” عام 1894 من قبل لودفيغ كويد، الذي وصفه بأنه إيمان بألوهيته، وبذخه المسرحي، وتوقه الشديد للانتصارات العسكرية، وهو ميل لممارسة الاضطهاد.
مضى على وصول بوتين إلى رئاسة بلاده أكثر من 21 عاماً. والآن لا يوجد مسؤول أو سياسي في الكرملين يجرؤ على مناقضته. ويحذر المؤرخون وعلماء النفس من أن هذا هو سبب فقدانه الارتباط بالواقع. وكان تسرب قبل سنوات تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، تحدثت خلالها عن الأزمة في شبه جزيرة القرم، وتم تسريب جزء من هذه المحادثة السرية إلى وسائل الإعلام الأميركية، والتي قالت فيها إنها “لم تعد متأكدة مما إذا كان بوتين يسيطر على أفعاله أو علاقاته بالواقع المعاش”.
الموت هاجس بوتين وتفاعلاته العقلية
يساور بوتين هاجس الموت، لأن متوسط العمر المتوقع للرجال في روسيا هو 68 سنة، وهو احتفل بعيد ميلاده التاسع والستين. هذا الهوس والخوف من الموت دفعاه إلى الانعزال تماماً منذ انتشار “كورونا”.
المسؤولون الذين يقابلونه، بما في ذلك وزراؤه وكبار مسؤولي الدول والجنرالات في القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية، لا يقومون بتطهير أيديهم وإجراء اختبار فايروس “كورونا” وحسب، بل يخضعون أيضاً للتطهير الميكانيكي لرؤوسهم. يقوم الجهاز الطبي في الكرملين برش المطهر على رؤوسهم وشعرهم وملابسهم، ومن ثم يرغمون ارتداء اللباس الطبي المعقم. كل هذا يحصل في قاعة مخصصة تمكن الروس من مشاهدتها بعدما سمح هو شخصياً للتلفزيون الحكومي بتصوير عملية التطهير، والتي تبدو وكأن الزائر يستحم ببدلته وحذائه.
يقول عالم السياسة الأميركي والباحث في الديكتاتوريات، فابيان بوركارد، الجمع بين العزلة والقوة الكاملة يمكن أن يكون خطيراً على نفسية أي شخص. قبل شهور وفي حوار تلفزيوني، اختزل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصية بوتين بكلمة واحدة عندما نعته “بالقاتل”، في حين وصفه الرئيس الفنلندي السابق بأنه أصبح شخصية متوترة غاضبة تغيب عنها الحكمة. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد ذكر عقب لقائه به أخيراً أن بوتين تغيّر كثيراً وأصبح أكثر توتراً. ورد في تقرير لمراسل صحيفة “صانداي تايمز” في موسكو مارك بينيت أن “بوتين مصمم على تحدي المنطق وشن حرب على أوكرانيا ما أثار الكثير من الأسئلة حول سلامته العقلية”.
ورأت تاتيانا ستانوفيا، المحللة السياسية في “آر بوليتك”: “إن بوتين عزل نفسه كثيراً خلال العامين الماضيين وأصبح بعيداً من آلة البيروقراطية ومن المؤسسة ومن النخبة. وأمضى وقته وحيداً يفكر بحاله ومخاوفه”. وتقول: “إنه لا يطلب الاستشارة من أحد ولكنه يضع المهمات ويطلب تنفيذها”. وكشف مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية المرتبط في وزارة الخارجية أندريه كورتنوف عن أنه لم يقدم النصح للمسؤولين الروس حول الغزو وأن القرار أدهشهم. وقال: “يمكنني القول إن كثيرين داخل وزارة الخارجية دهشوا وصدموا، وشعروا بالدمار بسبب ما حصل”. ونقلت “بي بي سي” عنه: “هذا خط أحمر اجتازته القيادة الروسية”… وأوضح المحلل تيموثي آش من شركة “بلو باي أسيت” أن “بوتين بات يُعتبر بمثابة التهديد الأكثر آنية لنظام الديموقراطية الغربية الليبرالية”. وقال لوكالة “فرانس برس”، “من المثير للاهتمام أن نسمع القادة الغربيين اليوم (…) إنهم يشعرون أن بوتين خذلهم ويهددهم”، ما جعله “المنبوذ الأول” بالنسبة إلى الغرب. وكتبت رئيسة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو على “تويتر” أن “روسيا قد تجد نفسها في عزلة سياسية واقتصادية غير مسبوقة ولفترة طويلة، مع شروع العواصم الأوروبية وواشنطن بفرض عقوبات بالغة الشدة عليها”. ووفقاً للمسؤول السابق عن الدعاية في الكرملين والمعارض للكرملين آلان غليب بافلوفسكي: “يتواصل بوتين مع العالم الخارجي من خلال دائرة ضيقة، وينزعج إن كان لدى أي منهم موقف أو رأي الخاص، لا سيما إذا كان مغايراً لموقفه، بالنسبة إليه فهذه كارثة”. وطرد بافلوفسكي من الكرملين عام 2011، لمعارضته عودة بوتين إلى الرئاسة مرة ثالثة، وقال إن الزعيم الروسي لم يعد يشبه الزعيم الذي عمل معه وقدم له النصح في الماضي. و”كان ميالاً لمناقشة الأمور مع مستشاريه وكان منفتحا على الآراء البديلة”، واصفاً الهجوم على أوكرانيا “بالضربة الخطيرة”، على الأمن الروسي، مضيفاً: “بوتين السابق لم يكن ليفكر بهذا أبداً، فقد كان رجلاً عقلانياً. اختفى كل هذا الآن ولديه هوس بأوكرانيا لم يظهره في الماضي. وهو يتفاعل مع التخيلات التي تتصارع في عقله”.
نظرة ثلاثية الأبعاد
البروفيسور الشهير جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شيكاغو، يرفض التقديرات السطحية السابقة، ويفضل أن يفهم سلوك الرئيس بايدن في ضوء ما يحيط به من أحداث وتطورات تاريخية. ومن الصعب العثور على عالم أو باحث في مجال العلاقات بين الدول بقوة وعمق وتأثير ميرشايمر، الذي تُدرس أعماله وكتاباته لكل طلاب العلاقات الدولية حول العالم منذ الربع الأخير من القرن الـ20 وصولاً إلى قرب نهاية الربع الأول للقرن الـ21.
وطبقاً لرؤية ميرشايمر، تحكم حسابات بوتين نظرة ثلاثية الأبعاد متكاملة ومترابطة، يبدأ أولها بفكرة توسع حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) وامتداده شرقاً في اتجاه حدود بلاده، وثانيها توسع وتمدد الاتحاد الأوروبي، وآخرها التبشير بحتمية تحقيق الديموقراطية الليبرالية على النسق الغربي في كل دول القارة الأوروبية. من هنا يؤمن بوتين يقيناً بأن هدف إسقاط نظام الحكم المركزي القوي في موسكو يبقى المحرك الأساسي لكل السياسات الغربية منذ انتهاء الحرب الباردة في أوائل تسعينيات القرن الماضي. ومن ناحية ثالثة، يرى بوتين أن الدعوات الأميركية لدعم وتمويل عمليات الانتقال الديموقراطي في دول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفياتية السابقة، تمثل تهديداً كبيراً للدولة الروسية القوية والمركزية، وبأن هدفها في النهاية إسقاط نظام الحكم في موسكو، واستبداله بنظام صديق لواشنطن والغرب.
يبدو أن هناك تحليلاً يشترك فيه كثر من المحللين الغربيين مفاده أن بوتين وجد في مؤتمر الديموقراطية الذي استضافته إدارة بايدن في كانون الأول الماضي إشارة تبرهن على إعادة تقسيم أميركي للعالم وعودة لمناخ الحرب الباردة وخطوة عدائية تضع واشنطن موسكو وبكين في جانب آخر.
يتجاهل خبراء الشأن الروسي ممن تكتظ بهم شبكات الأخبار الأميركية أن بوتين اعتقد بشكل خاطئ أن حالة الضعف الغربي، وغياب وجود قيادات تاريخية تقدر حجم التحديات المعاصرة وتعقيداتها، توفر له فرصة تاريخية لتحقيق خططه وطموحاته الامبروطورية. إذ رأى مقابله رئيساً أميركياً مُسناً تتدهور شعبيته لتقل عن 40 في المئة، وسط انقسام سياسي لم تشهد له الولايات المتحدة مثيلاً من قبل، ونمو تيار راديكالي بشكل مطرد في قيادات الحزب الديمقراطي وفي الكونغرس، يمثل ما يسمى اليسار التقدمي الذي لا يخفي تعاطفه مع روسيا وانبهاره بشخصيته. واعتبر أن مؤشرات استطلاعات الرأي التي كشفت أن 74 في المئة من الأميركيين لا يريدون أن تلعب بلادهم أي دور بارز في الأزمة الأوكرانية الجارية، وسط تدهور اقتصادي وارتفاع غير مسبوق في نسب التضخم.
استغل بوتين وجود رئيس وزراء بريطاني تطارده الفضائح الداخلية والتحقيقات البرلمانية، كما استغل وجود مستشار ألماني جديد في الحكم جاء على رأس ائتلاف ضمنه أحزاب اشتراكية ويسارية لا تعادي روسيا وتمقت الحروب. واستغل بوتين أيضاً وجود رئيس فرنسي لا يسيطر على هاجسه إلا إعادة انتخابه خلال أسابيع مقبلة. هذا جاء متسقاً مع تجاهل الغرب وأميركا المخاوف منذ 2014، على رغم من سقوط ما يقرب من 14 ألف قتيل أوكراني في معارك بين مناطق أوكرانيا الشرقية وحكومة كييف. ورفض الغرب منح أوكرانيا صفة الحياد لتصبح منطقة عازلة محايدة بين حلف الناتو وروسيا، فما كان من بوتين إلا أن استخدم كل أدواته المتاحة لتغيير واقع لا يرضيه على الأرض باستخدام القوة، وهي اللغة للأسف التي يسهل على الجميع فهمها، برأي الكسندر دوغين ملهم بوتين ومنظر مشروع اتحاد “اوروآسيا” وتقويض الثورات الملونة.
سردية بوتينية مزيفة للتاريخ
كيف يمكن إيقاف بوتين من استفزاز حرب عالمية جديدة، بخاصة بعد تهديده بالسلاح النووي بعد فشل مئات الاف من الجيش الروسي في كسر عزيمة الأوكرانيين وقاداتهم وفي مقدمهم الرئيس زيلنسكي؟
في حوار أجرته إذاعة “بلغاريا” الوطنية مع مدير برنامج السياسة الداخلية والهيئات السياسية في معهد “كارنيغي” في موسكو اندريه كوليسنيكوف قال رداً على سؤال عن ماهية ما يريده بوتين، “من الصعب على تفسير الأمر بالحجج المنطقية ربما في الحالة الراهنة يبدو أن العواطف تلعب دوراً ليس قليلاً في قرارات بوتين، واقصد سرديته الروسية المتخيلة للتاريخ التي تتطابق مع رأي وتفكير عدد كبير من الروس”. وأضاف: “هذا الجزء من السكان يتقبل هذه السردية لأحداث التاريخ القريب ولما يحصل الآن على الواقع. ولكن إذا ما تمعنا في ما يفعله، نجد أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالسيطرة على أوكرانيا كجزء من إمبراطوريته المتخيلة والتي تمثل الجزء الأكثر أهمية إلى جانب بيلاروسيا. هذه في الواقع ليست إلا محاولة لإعادة يانوكوفيتش إلى السلطة في أوكرانيا”.
وبرأي كوليسنيكوف”بوتين يريد أن يرغم أوروبا على السير ضمن قواعده، وهو بمطالبه عالية السقوف يقول للأوروبيين والأميركيين، إما أن تلعبوا وفقاً لهذه الخطوط والسياسية أو عليكم أن تواجهوا أوضاعاً جيوبوليتيكية جديدة”.
وأوضح، “إذا بدأت مفاوضات مع الجانب الأوكراني، وهو أمر مشكوك فيه، سيطلب بوتين من زيلينسكي أن يعلن أن أوكرانيا ستكون محايدة. عندما يحصل على ذلك ربما سيترك الرئيس الأوكراني حياً، ولكن من غير المرجح أن يسمح له في هذه الحالة بالبقاء في كرسي الرئاسة”.
إذاً من يستطيع إيقاف بوتين؟
يجيب كوليسنيكوف، “للأسف لا أحد في روسيا لديه النفوذ للقيام بذلك، إذ لا يوجد بديل أو أفكار عقلانية مغايرة، فهو حطم أي نوع من المنافسة في المجال السياسي العام في البلاد، الانتخابات والأحزاب وما إلى ذلك، وحتى في دائرته الداخلية الضيقة. كما أنه دمر المنافسة في أجهزته التي تتبع تعليماته وإرشاداته. وبالتالي لا يمكن العثور على شخصيات سياسية ومسؤولين لا يخافون غضبه وبطشه إذا تجرأوا وأبدوا ملاحظاتهم على قراراته، مهما كان شكل وجوهر هذه الآراء، وبالتالي فإن موافقتهم تحصل على كل ما يقول حتى وإن كان غير منطقي. لسوء الحظ المشكلة تتعدى القرارات السياسية التنفيذية إذ حتى الخبراء الاقتصاديين او من يسمون بالليبراليين من أفراد حكومته ومستشاريه، لا أحد بينهم بإمكانه إيقافه”.
يتزايد عدد الشباب نسبياً في طاقم بوتين وهم يتمتعون بصفتهم نخبة جديدة من التكنوقراط الحاصلين على شهادات من جامعات أميركية وغربية مرموقة، لكنهم لا يكشفون عن نزعاتهم الليبرالية خوفاً من بطشه؛ فلا أحد من مساعديه الجدد يعتنق أي شيء أشبه بوجهة نظر ليبيرالية؛ بل إنهم في واقع الأمر لا يُظهرون أي التزام أيديولوجي أو طموحات على الإطلاق. إنهم في الحقيقة كما وصفهم الزعيم الشيشاني الموالي للكرملين رمضان قديروف “جنود بوتين”.
تشير استطلاعات الرأي التي أجراها مركز “ليفادا” المستقل لقياس اتجاهات الرأي العام الروسي، قبل اجتياح اوكرانيا، إلى أن 50 في المئة ممن تم استطلاع آرائهم يوافقون على الغزو العسكري، مقابل النسبة ذاتها من الرافضين.
يتضح من الاستطلاع أنهم لا يزالون يضمرون مشاعر ايجابية لأوكرانيا، فمعظم الروس لديهم الكثير من الأقارب والمعارف والأصدقاء في أوكرانيا. هذا وكان مركز ليفادا أجرى بالاشتراك مع المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية في كييف دراسة حول علاقة الأوكرانيين بروسيا. يتضح من الاستطلاع أن 69 في المئة من الروس لديهم موقف سلبي من الحكام في اوكرانيا، فيما ينتشر موقف سلبي بين الأوكرانيين من الكرملين، وتصل النسبة إلى 73 في المئة. ويرجح كوليسنيكوف أن أي استطلاع جديد للرأي “ستكون مؤشراته ومعطياته مختلفة تماماً”، متوقعاً أن ترتفع نسبة الأوكرانيين الذين لا يكنون المشاعر الايجابية للحكام الروس وربما ستصل إلى أكثر من 80 في المئة”، ما يعني أن العداء لبوتين ازداد بين الأوكرانيين بعد عدوانه على بلادهم.
بوتين بعد فشل القوات العسكرية في تحقيق أي تقدم في العمليات الحربية على الأرض يعيش صدمة كبيرة، بعدما تجرع سم المقاومة الأوكرانية المستميتة. لقد كان يعيش في عالم متخيل رسم ملامحه لنفسه يؤمن فيه بأن الأوكرانيين سيستقبلونه بالورود والخبز والملح، ربما لأنه لم يقرأ استطلاعات الرأي، إذ لم يجرؤ أي من مستشاريه على وضعها على مكتبه.
يقول كولينسنيكوف “حتى إن كان اطلع عليها ما كان ليصدقها مطلقاً، فهو شخص لا يثق بأحد ممن حوله، ويصدق فقط الاستطلاعات التي تجريها الوكالة الفيدرالية للأمن والاستخبارات الروسية”.
هل من أمل من المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا؟
ربما نشهد إجماعاً غير مسبوق بين المحللين والمراقبين بأن أي مفاوضات ستجرى، محكوم عليها بالفشل، لأن بوتين هو من يحدد مساراتها وربما أيضاً يحدد النتائح التي يسعى من أجلها، بغض النظر عن هوية الوسيط وتجربته في مثل هذه الأزمات.
الحكومات جميعها سواء أكانت استبدادية أم ديموقراطية، فهي تلجأ إلى آلية “التفاوض” مع ضرورة المعرفة المسبقة بأن الاختلاف بين النظامين يتمثل في أن الأنظمة الاستبدادية لا تجد نفسها ملزمة بالامتثال لمتطلبات هذه المفاوضات. يتمتع بوتين بميزة وبأفضلية فائض القوة، لهذا فإن المفاوضات في كل الأحوال ستكون غير متكافئة بغض النظر عن البلد الذي ستعقد فيه، ذلك أن روسيا ستشترك فيها من موقع الطرف الأقوى عسكرياً.
فوت “الحلف الأطلسي” عام 2014 بعد احتلال روسيا جزيرة القرم وضمها إلى “الاتحاد الفيدرالي الروسي”، فرصة رسم عقيدة عسكرية جديدة تتفاعل مع المتغيرات الخطيرة في السياسة الخارجية الروسية، وتتضمن مفاهيم متشددة للأمن الأوروبي والأطلسي، لا تستخدم مفهوم “الحرب”، ولكن “ليس السلام” أيضاً، بخاصة في ما يتعلق باستراتيجية مكافحة التهديد الروسي المتنامي والمتصاعد بوتيرة سريعة منذ عام 2000 وحتى الآن. وبحسب الباحث في الشؤون الروسية والأوروبية ايفو ماييف، فإن “استراتيجية روسيا تجاه الغرب انطلقت إلى التنفيذ منذ عهد ريغان، عندما تكثفت المجسمات السامة والجيواستراتيجية الخانقة لشبكات الغاز الروسي”.
كانت دول أوروبا الشرقية طوال الوقت الوحيدة التي ظلت تردد أفكارا لم تلق صدى عند الغرب، فقد كانت تلح على أن الحرب لم تنته وأن روسيا تستعد للانتقام لسقوط الاتحاد السوفياتي، إلا أن الحكومات الغربية أصرت على تجاهل ذلك ورفضت الاستماع لهذه الهواجس التي أصبحت واقعا معاشا مع وقوع اوكرانيا كأول ضحية في شباك الانتقام الروسي وما ينجم من جرائم حرب يرتكبها بوتين بحق الشعب الأوكراني. والمفارقة المؤلمة أنه سيتحتم على هذه البلدان استقبال مئات الاف اللاجئين الاوكرانيين الفارين من الحرب، وربما تكون الضحية التالية لجرائم بوتين المرتقبة.
حتى الآن يسود الغموض والضبابية حول مسارات الحرب و القتال، واذا ما كان العدوان سينتهي قريبًا بهزيمة بوتين، او ستدخل أوكرانيا في حال وقعت لقمة سائغة لروسيا حربا أهلية، ومقاومة منظمة، لا تستثني قيام الغرب بإرسال شركات عسكرية وأمنية خاصة إلى أوكرانيا لمساعدة الأوكرانيين في استعادة بلادهم.
تتأسس العقيدة الإستراتيجية لروسيا على شيء واحد يعرف بتعبير “الأيقونة والفأس”. وهناك أشياء كثيرة يمكن فعلها بالأيقونة والفأس…
درج
———————–

ماذا تريد روسيا في أوكرانيا؟/ فيتالي نعومكين
في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تصعيدٌ حادٌّ في التوتر في العلاقات بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى، ناجم عن رفضهما القاطع للرد على مقترحات موسكو بتزويدها بضمانات أمنية رسمية وبالتالي ملزمة.
المطالب الرئيسية لموسكو هي ضمانات موثقة لمنع المزيد من التوسع نحو الشرق لحلف «الناتو»، والامتناع عن نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، وإعادة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى الوضع الذي كان عليه في 1997 عندما تمَّ التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا وحلف الناتو. إن قبول أوكرانيا في الناتو يعني تقريب البنية التحتية العسكرية للناتو من حدودها، الأمر الذي سيختصر وقت وصول الصواريخ الأميركية إلى موسكو إلى بضع دقائق! مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن كييف تحدد في وثائقها العقائدية مهمة بسط السيطرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد الروسي، وأن أتباع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية يكتسبون المزيد من النفوذ في أوكرانيا، من الواضح أن انضمام الأخيرة إلى الحلف سيشكل تهديداً وجودياً لروسيا، ويدفعها للمواجهة مع الناتو.
لقد تم تجاهل مطالب موسكو في ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المسودات التي قدمتها، بل وتم التأكيد على مبدأ حرية قبول أعضاء جدد في الناتو.
ذكر فلاديمير بوتين زملاءه الغربيين بأن مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة يشمل الالتزام الوارد في العديد من الوثائق الدولية بعدم تعزيز أمن دولة على حساب أمن الدول الأخرى. كما شدد الرئيس الروسي على أنه وفقاً للمادة 10 من معاهدة 1949 يمكن لحلف شمال الأطلسي دعوة دول أخرى إلى عضويته، لكنه ليس ملزماً على الإطلاق بقبولها، بيد أن كل تحذيرات الرئيس الروسي كانت عديمة الجدوى، رغم أنه حذر بإصرار من خطر تجاوز الغرب «للخطوط الحمراء». وبالتزامن مع الضغط القوي على موسكو، كثف الغرب من الضغط الاقتصادي أيضاً عليها، عبر اتخاذه قرارات بفرض عقوبات جديدة.
ترافق التوتر بين روسيا والغرب، والذي وصل إلى مستوى حرج، مع تفاقم حاد للوضع في أوكرانيا نفسها. صعدت كييف من ضغوطها القوية على السكان الناطقين بالروسية الذين يتعرضون للتمييز في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والذين يدافعون عن حقوقهم، واستمر القوميون الراديكاليون في التهديد بالانتقام من كل من يختلف مع أفكارهم المتطرفة، وباتت تتعرض بلدات هذه الجمهوريات للقصف على نحو متزايد، أدى إلى تدمير البنى التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين. رفضت كييف بعناد الامتثال لاتفاقيات مينسك، ورفضت كذلك بشكل قاطع الدخول في مفاوضات مع دونيتسك ولوغانسك. لم تكن هناك حاجة حتى للحديث عن اعتراف كييف بالعودة الطوعية لشبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا. تعززت قناعة راسخة في روسيا، بأن كل ما يحدث «كان نتيجة سياسة الغرب التي استمرت ثماني سنوات لإنشاء نظام عدواني يكن الكراهية للروس على أراضي أوكرانيا مع إضفاء الشرعية على تشكيلات النازيين الجدد». وصلت الأمور إلى درجة أن الرئيس الأوكراني بدأ في تسمية السكان الناطقين بالروسية في جنوب شرقي البلاد بـ«القطعان» بدلاً من البشر. إن عدم حماية هؤلاء الأشخاص بالنسبة لبوتين يعني فقدان الشرعية في أعين الشعب الروسي، الذي بات النموذج الوطني في مزاجه يزداد قوة.
أصبح واضحاً لبوتين أنه: لم يبقَ إلا القليل، وسيتم تجاوز نقطة اللاعودة، ستنضم أوكرانيا بسرعة إلى الناتو، وسيتم نشر البنية التحتية العسكرية للتحالف فيها، بهدف تدمير روسيا.
كانت حسابات القيادة الروسية حتى وقت قريب جداً تبنى على أساس الأساليب السياسية والدبلوماسية، لكن الضغط القوي من الغرب تطلب التفكير في الإجراءات العسكرية، خصوصاً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بدأوا فعلياً في تزويد أوكرانيا المغرورة بالأسلحة الحديثة. أجرت روسيا بنجاح (وبشكل شرعي تماماً) تدريبات لقواتها المسلحة بالقرب من حدودها الغربية، بيد أن هذه الرسالة الموجهة إلى جيرانها لم تُستوعب. كانت النخبة الأوكرانية الحاكمة، التي تُدار من الخارج، تفقد بشكل يائس فرصتها الذهبية لتصبح دولة عازلة مؤثرة ومحايدة بين روسيا والغرب، وحكمت على نفسها بتفاقم أكثر حدة للأزمة في العلاقات مع جارتها الشرقية الكبرى، والتي يربطها معها تاريخ مشترك وتقارب عرقي وحضاري.
في ظل هذه الظروف، فتحت روسيا الأبواب أمام اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإيوائهم في الأقاليم الروسية، حيث وصل مئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين لذلك. وفي 21 فبراير (شباط)، من أجل حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بناءً على طلب قيادتهم، وبدعم من البرلمان الروسي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يعترف باستقلال هاتين الجمهوريتين. في الوقت نفسه، شدد على أنه في الماضي، «قامت روسيا بكل ما هو ممكن للحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا…. لكن من دون فائدة». الآن تمت المصادقة على معاهدتين – بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. تسببت هذه الإجراءات، كما هو متوقع، في تصاعد الخطاب المعادي لروسيا من الغرب ومن النخب الحاكمة في أوكرانيا نفسها.
هنا أدرجت إجراءات أكثر جدية على جدول الأعمال لتحييد التهديد بضربة مفاجئة ضده. نتيجة لذلك، في 24 فبراير، اضطر الرئيس الروسي لإطلاق عملية عسكرية خاصة لقواته المسلحة، بدعم من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين على الأراضي الأوكرانية، والتي هدفها إنجاز مهمة إجبار كييف على السلام.
تتمثل المصلحة الاستراتيجية الرئيسية لروسيا في أن تكون لها دولة صديقة على حدودها الغربية، وليس نظاماً فاسداً يهدد وجودها باستمرار ويرتكب جرائم دموية ضد مواطنيه والمواطنين الروس الذين يعيشون على أراضي هذه الدولة. الطريقة الوحيدة للحماية من ذلك هي نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها. في الوقت نفسه، صدرت أوامر للقوات المتقدمة بالسعي لتفادي الدمار والخسائر بين السكان المدنيين. يُسمح لجنود الجيش الأوكراني الذين ألقوا أسلحتهم، إذا تعهدوا عدم المشاركة في الأعمال القتالية ضد الجيش الروسي، بالعودة إلى ديارهم. أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة هو تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، عن طريق توجيه ضربات ساحقة، من دون أن تمس المدن والمناطق السكنية. تقتصر عمليات القوات الجوية الروسية بشكل عام على توجيه الضربات الدقيقة، بهدف الحفاظ على البنية التحتية المدنية، لكن هزيمة النظام الأوكراني أمر لا مفر منه. رغم أن موسكو الرسمية كما هو متوقع لا تكشف جميع أوراقها، لكنه يمكننا توقع إحكام سيطرة الجيش الروسي على كامل البلاد أو على معظمها، والسقوط القريب لسلطة كييف، وكخيار، تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة، تعكس مصالح جميع فئات سكان البلاد وستتولى زمام الأمور، في تطهير أوكرانيا من هيمنة القوميين الراديكاليين، ونزع السلاح والانتقال إلى الحياد.
* خاص بـ«الشرق الأوسط»
——————————
الدروس الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية
الوضعية الراهنة ليست إلا حلقة جديدة في مسلسل مستمر منذ قرابة الثلاثين عاماً، وهو يجسد صراع روسيا والولايات المتحدة من أجل توسيع نطاق تأثير ونفوذ كل واحدة منهما.
تصوير: تانيا بوغان
مجموعة “جغرافيات متحركة”*
الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها في بداية هذه السنة: ما الذي تحاول روسيا فعله؟ لماذا تحشد آلاف الجنود على حدودها مع أوكرانيا؟ وفي حالة ما اجتاحت أوكرانيا، ما تبعات ذلك على باقي القارة الأوروبية؟ فيما يلي جولة جيوسياسية صغيرة لفهم الوضع.
أجواء الاحتقان والتوتر بين أوكرانيا والنظام الروسي ليس وليدة اليوم. يجب أن نرجع بالزمن إلى نهاية الحرب الباردة لفهم الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين. انهيار النظام السوفياتي وتقطيع أوصال الاتحاد السوفياتي والهزيمة المذلة أمام العملاق الأمريكي، كلها إهانات مُرّة لم تستطع روسيا ابتلاعها بسهولة. بلا شك، أفضى انفراج العلاقات في تسعينات القرن الفائت إلى تقارب بين القوتين العظميين، لكنه تأسس قبل كل شيء على قاعدة برنامج “علاج بالصدمة” (1)، من تخطيط صندوق النقد الدولي (وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية) أدى إلى الخصخصة الشاملة (التصفية بالأحرى) لقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي لفائدة اوليغارشيين محليين وقوى أجنبية (2). هناك عامل أساسي ساهم أيضاً في هذا التقارب: الوعد الذي قطعته الولايات المتحدة وألمانيا لغورباتشوف بعدم توسع “الناتو” (حلف الشمال الأطلسي) في اتجاه الحدود الروسية.
صحوة الإمبريالية الروسية
نقض هذا العهد بعد أقل من عشر سنوات مع انضمام المجر وبولونيا وجمهورية التشيك إلى الحلف العسكري الأطلسي. بعد ذلك، أثار اعتزام الولايات المتحدة نصب دروع مضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية، وكذلك دعم الدول الغربية لعدة ثورات في جمهوريات سوفياتية سابقة (ثورة الورود في جورجيا سنة 2003، وخاصة الثورة البرتقالية في أوكرانيا في السنة التالية)، حساسية روسيا (بقيادة بوتين آنذاك) لكنه منحها خاصة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.
بلغت هذه التدخلات أوجها مع الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في جورجيا سنة 2008، وبالطبع ضم القرم في 2014 (شبه جزيرة تقع جنوب أوكرانيا وتشكل نقطة استراتيجية بالنسبة لروسيا لأنها تسهِّل لها الوصول إلى البحر الأسود، وبالتالي إلى مسالك التجارة البحرية الدولية) والدعم المقدم (دون اقرار رسمي) إلى الانفصاليين في “دونباس، المنطقة الواقعة على الحدود الفاصلة بين روسيا واوكرانيا. الوضعية الراهنة ليست إذاً إلا حلقة جديدة في مسلسل مستمر منذ قرابة الثلاثين عاما، وهو يجسد صراع روسيا والولايات المتحدة من أجل توسيع نطاق تأثير ونفوذ كل واحدة منهما.
حرب باردة جديدة؟
انطلاقا مما سبق، هل يمكن القول اننا عدنا إلى زمن الحرب الباردة؟ هذه النظرة للأمور تبدو للوهلة الأولى وجيهة، لكنها تغفل عن حقيقة ان الاختلافات الايديولوجية التي لعبت دورا جوهريا خلال الحرب الباردة لم تعد قائمة. الأسوأ من ذلك ان التحاق روسيا المتحمس بالرأسمالية المعولمة والمنفلتة من الضوابط يزج بها في قلب التناقضات الملازمة لهذا النظام، ومنها ضرورة ايجاد منافذ جديدة والوصول إلى موارد جديدة خارج حدود البلاد. ومن البديهي ان هذا التوسع لا يمكن ان يتم إلا على حساب القوى الأخرى العالقة في المعضلة نفسها. يلخص الجغرافي ديفيد هارفي الأمر كالتالي: “كل المناطق التي تسيطر عليها الرأسمالية تنتج فائض رساميل فتبحث عن حلول عبر توسيع مجالها الجغرافي، مما يؤدي حتما إلى صراعات جيوسياسية للتأثير في مناطق أخرى أو السيطرة عليها” (3).
في نهاية المطاف، ما نشهده الآن ليس إلا مواجهة جديدة بين إمبرياليتين يلتجأ فيها الجانب الروسي إلى الممارسات والضربات القذرة نفسها التي تلجأ اليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرن:
• التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى. فبالإضافة إلى أوكرانيا وجورجيا، فإن دعم روسيا لبشار الأسد لا يمكن إلا أن يذكّرنا بالديكتاتوريات العديدة التي دعمتها – وحتى نصّبتها – الولايات المتحدة في العقود الأخيرة (إيران، تشيلي، البرازيل، نيكاراغوا، هايتي، زائير سابقا، العراق، الخ.) (4).
• اسناد قوى انفصالية لضرب استقرار البلدان وصناعة دول “صديقة”. هنا أيضا تبدو سياسة الكرملين مألوفة، اذ سبق ان شاهدناها مثلا في “بنما”، المنطقة التي اقتُطعت من كولومبيا في 1903 بدعم من الولايات المتحدة لبسط سيطرتها على قناة بنما، وكذلك في منطقة البلقان لما دعمت الولايات المتحدة استقلال كوسوفو في 2008 على الرغم من مخالفته للقانون الدولي.
• الاستعانة بخدمات الميليشيات غير الرسمية. لا يمكننا إحصاء الحوادث والقضايا التي تورطت فيها وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” (اغتيال قادة بلدان، تنظيم انقلابات، تجسس، فساد، حروب أهلية) خدمة للمصالح الأمريكية (5). لكن لا يبدو ان ميليشيا “فاغنر” تقل عنها شطارة. تنشط هذه الشركة العسكرية، التي تعمل لحساب الكرملين بشكل غير رسمي، في أغلب ميادين المعارك التي تلعب فيها روسيا دوراً. فمن سوريا إلى مالي، مروراً بأفريقيا الوسطى وليبيا، نجد ميليشيا “فاغنر” في قلب الاتفاقيات الأمنية التي تخدم في نهاية المطاف المصالح الروسية في البلدان المعنية.
الجرافيك:
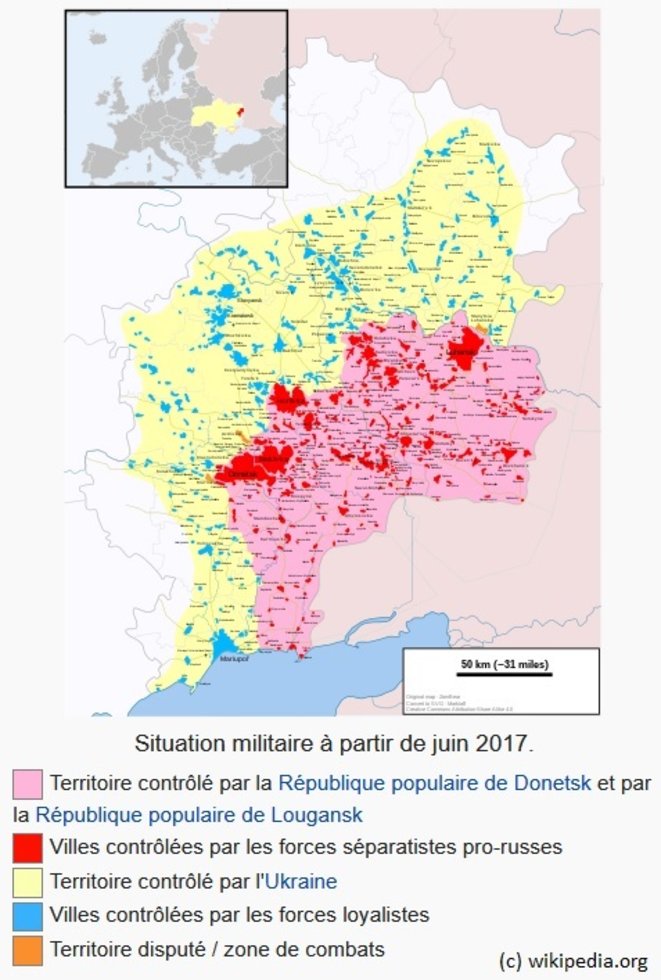
• بالوردي الإقليم الذي تسيطر عليه كلا من “جمهورية دونتيسك الشعبية” و”جمهورية لوغانسك الشعبية”
• بالأحمر المدن التي تسيطر عليها القوى الانفصالية الموالية لروسيا.
• بالاصفر الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
• بالأزرق المدن التي تسيطر عليها القوى الموالية لأوكرانيا
• بالبرتقالي المناطق المتنازع عليها و/أو التي تشهد مواجهات مسلحة.
آلة البروباغندا تعمل بنشاط
بطبيعة الحال لا تُبرِّر أي سياسة إمبريالية نفسها بأهدافها الحقيقية، بل ترافقها حملة اتصالية تُخفي المصالح الفعلية تحت غطاء من “الدوافع المحمودة”. “الحقيقة هي دائما الضحية الأولى للحرب “، يقول روديارد كبلينغ. وفي حالتنا هذه، يخوض الطرفان حرباً دعائية مكثفة طبقاً لل”مبادئ الأساسية للدعاية الحربية” الشهيرة التي صاغتها المؤرخة البلجيكية آن موريلي (6).
يبدأ الأمر بتحميل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر. وفعلا يلقي الروس كما الأمريكيين باللائمة على بعضهما البعض، فلا أحد منهما يرغب في الحرب، لكنه قد يُكْره على الانخراط فيها بسبب ما يفعله الطرف الآخر. هذه دعاية كلاسيكية مثلها مثل شخصنة الشر كما يتجلى ذلك في الصورة الشيطانية لفلاديمير بوتين التي يتم تسويقها في الغرب. هذا الأخير يجسد لوحده التهديد الروسي، مما يعني ضمنيا أن بلداً تعداده أكثر من 140 مليون نسمة، بكل حقائقه الاجتماعية المعقدة، وتناقضاته الداخلية، يُختزل في إرادة وشخصية رجل واحد. ويبرر كل معسكر تأجيج الصراع بدوافع انسانية بطبيعة الحال. من جهة، الدفاع عن سلامة ووحدة الأراضي الأوكرانية، ومن الجهة الأخرى التصدي للاضطهاد الذي قد يكون تعرض له الانفصاليون الموالون لروسيا. وبطبيعة الحال أيضاً هناك الاختزال الدائم للأمور في ثنائيات متضادة، دون نسبية أو تباينات: ضروة الانحياز لهذا المعسكر او ذاك! وكما تقول آن موريلي “خلال أي حرب، كل من يريد البقاء حذراً فيستمع إلى حجج المعسكرين المعنيين قبل أن يصيغ وجهة نظر، أو يشكك في الرواية الرسمية، يتم التعامل معه فوراً كمتواطئ مع العدو”. هذه قصة قديمة..
باختصار، ما نشهده اليوم لا يبدو باي حال من الأحوال أمراً فريداً غير مسبوق، بل يشكّل حالة نموذجية لمواجهة متجددة بين قوى امبريالية (على الأقل تعتبر نفسها كذلك). لكن هذا لا يعني ان الوضع لا يبعث على القلق. فعند اندلاع الحرب يدفع المدنيون الضريبة الأثقل في حين يحصد تجار السلاح (في مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا) المكاسب الأكبر. أما الاتحاد الأوروبي فيبدو دوره هامشي جداً في هذا الصراع، والسبب هو بلا شك الحاجة الكبيرة للعديد من أعضائه للبترول والغاز الروسيين.
______________
*مجموعة “جغرافيات متحركة” تتألف من أربعة باحثين من بلدان وجامعات عديدة، أسسوا “موقعاً تربوياً” لفهم العالم من خلال أماكنه كما يقولون: مانوك بورزاكيان (لوزان، سويسرا)، جيل فوماي (جامعة السوربون/المركز الوطني للبحث العلمي)، رينو دوتيرم (آرلون، بلجيكا)، ناشيديل روياي (جامعة بوردو، فرنسا).
_____________
• النص منشور بالأصل في “مدونة ميديابارت”، 23 شباط/ فبراير 2022 https://bit.ly/3tkemz1
• ترجمه من الفرنسية محمد رامي عبد المولى
______________
1- ملاحظة المترجم: مصطلح اقتصادي يستعمل للدلالة على سياسات “الإصلاح” الاقتصادي السريعة والقاسية: تحرير كامل للسوق والأسعار، خصخصة شاملة، انفتاح كلي على الأسواق العالمية، الخ.
2- جوزيف ستسغليز، الوهم الكبير، باريس، دار نشر فيّار، 2002.
3- ديفيد هارفي، الجغرافيا ورأس المال، نحو مادية تاريخية-جغرافية، باريس، دار نشر سيلابس، 2010.
4- تلخص أعمال ناعوم تشومسكي بشكل مميز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية
5- مارك زيبزاور، العمليات القذرة لوكالة الاستخبارات المركزية، دار نشر “L’Esprit Frappeur” باريس، 2002.
6- آن موريلي، المبادئ الأساسية للدعاية الحربية، بروكسل، دار نشر آدن، 2010.
السفير العربي
—————————–

نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة: مغامرة روسيا في أوكرانيا تعيد تشكيل النظام العالمي برمته
سواء نجحت المغامرة الروسية في أوكرانيا أو أخفقت، فإن عملية إدماج روسيا في المجال الأوروبي قد توقفت. تعود أوروبا إلى الانقسام من جديد، وإن على أساس خطوط تختلف إلى حدٍّ كبير عن حدود الحرب الباردة.
أخيرًا، وفي فجر 24 فبراير/شباط 2022، كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حقيقة خططه. بعد حشد عسكري على حدود أوكرانيا الشرقية والجنوبية والشمالية، استمر لعدة شهور، وتصريحات لم تتوقف عن إنكار الاتهامات الأميركية بأن روسيا تعد جيشها لغزو أوكرانيا، بدأت القوات الروسية بالفعل عملية عسكرية شاملة وعميقة ضد الجار الأوكراني الذي تصفه القيادة الروسية بالشقيق.
في اليوم الأول من الحرب، بدا أن حركة الجيش الروسي تمضي سريعًا، وأن الوحدات الروسية المدرعة تحرز تقدمًا سريعًا في الجنوب الشرقي وشمالي العاصمة الأوكرانية، وتدور معارك كرٍّ وفرٍّ بين الطرفين في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا. في اليومين الثاني والثالث من الحرب، أصبح واضحًا أن المقاومة الأوكرانية أكثر صلابة مما توقع القادة الروس، وأن حركة القوات الروسية تباطأت بصورة ملموسة؛ بينما قالت مصادر غربية: إن العملية العسكرية الروسية أخفقت حتى الآن في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
في الوقت نفسه، وبعد تردد أوروبي، بدأت بريطانيا، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، إعلان حزم من العقوبات المالية والاقتصادية بالغة القسوة على مؤسسات وشخصيات روسية، على الرئيس بوتين ووزيري دفاعه وخارجيته، إلى جانب حظر شبه كامل على حركة الطيران المدني الروسي. كما ذكرت تقارير في أواخر مساء 26 فبراير/شباط أن القوى الغربية اتفقت على فصل بنوك روسية رئيسة من نظام سويفت، ومنعت روسيا من التبادل في عدد من العملات الدولية، الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
والمؤكد، رغم أن الفصل عن سويفت -الذي يعتبر سلاحًا ماليًّا نوويًّا- لم يُتَّخذ بالكامل، أن ما أُعلن من عقوبات في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب لن يكون آخر الإجراءات الغربية المناهضة لروسيا.
بدأت العلاقات الروسية-الأوكرانية في التأزم منذ خريف العام الماضي، ولكن الحرب لم تكن حتمية بالضرورة. فكيف ولماذا أقدمت روسيا على اتخاذ قرار الحرب، التي تماثل في تأثيرها على النظام الدولي قرار ألمانيا النازية بغزو تشيكوسلوفاكيا في 1939، أو انهيار جدار برلين؟ لماذا تتحمل القوى الغربية، والولايات المتحدة، على وجه الخصوص، جزءًا لا يقل من المسؤولية عن اندلاع الحرب؟ وأية آثار إقليمية ودولية يمكن توقعها لهذه الحرب، بغضِّ النظر عن نجاح بوتين أو تعثر قواته في تحقيق انتصار سريع؟
طريق بوتين إلى الحرب
بدأ نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا، حسب الصور المرصودة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وعندما بدأت واشنطن في التساؤل حول حقيقة الحشود الروسية، عكست الردود الروسية اضطرابًا سياسيًّا واضحًا. في مرات، قالت موسكو: إن الجيش الروسي يقوم بتحركات تدريبية دورية داخل الأراضي الروسية، وأن ليس ثمة نوايا عدوانية ضد أوكرانيا. في مرات أخرى، برَّر المسؤولون الروس الحشود بالمخاوف من تجاهل كييف للالتزامات التي فرضتها اتفاقية مينسك لحل الصراع الدائر في منطقة دونباس. ولكن، وما إن بدأت الاتصالات الأميركية-الروسية المباشرة، على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى الرئيسين، تحدثت روسيا بلغة تربط حشدها العسكري بمطالبها الأمنية، غير المستجدة في الحقيقة، سيما مطالبتها الغرب بالتعهد المكتوب والقاطع بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، لا حاضرًا ولا مستقبلًا، وسحب منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ من رومانيا وبلغاريا، التي تقول موسكو: إن من السهل تحولها إلى منظومات هجومية في وقت قصير.
في 28 يناير/كانون الثاني 2022، سلَّمت السفارة الأميركية في موسكو المسؤولين الروس ردَّ واشنطن على ورقة المطالب التي كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تقدم بها لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن. والواضح أن مضمون الرد الأميركي لم يكن مرضيًا لروسيا، وهذا ما أكده الرئيس بوتين في بداية لقائه بالرئيس الفرنسي، ماكرون.
خلال الأيام القليلة التالية، صعَّدت روسيا من تحركها في جوار أوكرانيا بإطلاق مناورات عسكرية ضخمة مع الجيش البيلاروسي؛ وفي 2 فبراير/شباط، عقد بوتين جلسة مباحثات مع نظيره الصيني في بيجين، انتهت بإصدار بيان يعد بتعاون لا حدود له بين الدولتين، كتب بصيغة أقرب إلى التحالف منها إلى مجرد التعبير عن التقارب وعلاقات الصداقة.
في 15 فبراير/شباط، وبعد أن تيقنت موسكو من أن الغرب لن يستجيب لمطالبها الأمنية، ولا حتى بصورة جزئية، بدأ العد التنازلي نحو غزو أوكرانيا. مرَّر البرلمان الروسي مشروع قانون يوصي السلطة التنفيذية بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، والواقعتين في الحقيقة تحت الحماية الروسية. وكان واضحًا أن قرار البرلمان الروسي قُصد به توفير غطاء سياسي يمكنه تسويغ الحرب، سيما أن الانفصاليين يسيطرون على أربعين بالمئة فقط من الحدود الإدارية لدونيتسك ولوغانسك، ولن يكون من الصعب الاستعانة بهم لإخراج الجيش الأوكراني من مناطق الانفصاليين الواقعة تحت سيطرته.
في 19 فبراير/شباط، ووسط ادعاءات قيادات الانفصاليين بأن الجيش الأوكراني يصعِّد قصفه لأهداف مدنية في مناطقهم، بدأت عملية إجلاء لسكان مدن دونيتسك ولوغانسك القريبة من خطوط المواجهة. صُوِّرت عمليات الإجلاء وبُثَّت أحيانًا على المباشر في محطات التلفزة الروسية؛ ولكن التدقيق في التفاوت الملحوظ بين أرقام اللاجئين المحتملين المعلنة، وحجم مراكز استقبالهم في الجانب الروسي من الحدود، يشير إلى أن أرقام اللاجئين مضخمة إلى حدٍّ كبير.
في 21 فبراير/شباط، عقد بوتين جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي الروسي، يبدو أنها سُجِّلت بكاملها ثم بُثت بعد ساعات قليلة على الهواء لأهداف دعائية بحتة. كان مشهد الجلسة غريبًا بكل المعايير، حيث اصطف كبار مسؤولي الدولة الروسية أمام رئيسهم، البعيد عدة أمتار خلف مكتب مرتفع قليلًا عن مستوى مرؤوسيه. الهدف الحقيقي من الجلسة كان إقناع الرأس العام الروسي بأن كبار رجال الدولة متفقون على ضرورة اتخاذ سلسلة خطوات، وبالخصوص التصديق على قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغخاضعةانسك. ولكن ما شاهده الروس كان في الواقع مواقف متباينة، وعدم اتفاق ملموس، من أعضاء مجلس الأمن القومي، سيما موقفا رئيس جهاز الاستخبارات الروسية ورئيس الوزراء.
مهما كان الأمر، فبعد ساعات فقط من بث جلسة مجلس الأمن القومي، ألقى الرئيس الروسي خطابًا طويلًا، لم يخل من الغضب والشعور باليأس، رشح بأنه كتَبَ شخصيًّا معظمه. ردَّد بوتين ذات المقولات، التي استعرضها في مقالة له نُشرت في يوليو/تموز 2021 على موقع الكرملين الإلكتروني، خصوصًا قناعاته بأن الروس والأوكرانيين هم في الحقيقة شعب واحد، تجمعهم روابط الدم والتاريخ والثقافة، وأن أوكرانيا كيان صنعه لينين بعد اختلاف القادة الشيوعيين حول المسألة القومية في الاتحاد السوفيتي، وأن أوكرانيا ما كان يجب أن تصبح دولة مستقلة. تحدث بوتين طويلًا عن المخاطر الاستراتيجية التي تواجه روسيا بفعل نكث الغرب عن وعوده بعدم توسع الناتو شرقًا، وأعلن عن أنه سيقوم خلال لحظات بتوقيع قرار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين في الشرق الأوكراني.
وهذا ما قام به بالفعل، في بث حي للشعب الروسي والعالم أجمع. خلال الساعات التالية، لم تتوقف موسكو ودوائر رئاستي دونيتسك ولوغانسك عن إصدار البيانات التي تفيد بتعرض المناطق الانفصالية لقصف مستمر، وبأسلحة ثقيلة، من الجيش الأوكراني. وفي صباح يوم 24 فبراير/شباط، خرج الرئيس بوتين في خطاب قصير نسبيًّا، برَّر فيه قرار إعلان الحرب، وإن لم يستعمل كلمة الحرب وإنما عملية عسكرية خاصة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة، وأنها خاضعة كليا للغرب، وأنها تُحكَم من قبل حفنة من النازيين، وأنها باتت تمثل تهديدًا حقيقيًّا للدولة الروسية وبقائها.
لم تكن ضرورية ولا حتمية
طبقًا للنيويورك تايمز، تسلَّمت إدارة بايدن معلومات تتعلق بمخطط للحشد الروسي حول أوكرانيا منذ سبتمبر/أيلول الماضي 2021، أي قبل شهر على الأقل من انتشار التقارير التي أكدت وجود تلك الحشود، وأن الإدارة الأميركية أبلغت الجانب الروسي، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، بمعرفتها بما يحدث. وهذا بالطبع ليس مستبعدًا، فالولايات المتحدة تحتفظ بمصادر استخبارية في كافة مستويات الدولة الروسية منذ ما قبل نهاية الحرب الباردة.
ولكن إدارة بايدن، سواء قبل بدء تطور الوضع إلى مستوى الأزمة، أو بعده، أو مع بدء الاتصالات بين وزيري الخارجية، الأميركي والروسي، أو خلال الاتصالات بين بايدن وبوتين، لم تُبْدِ أي استعداد للتفاوض حول جوهر المطالب الروسية الأمنية. أكدت واشنطن في أكثر من مرة، بما في ذلك مساء يوم 25 فبراير/شباط 2022، ثاني أيام الحرب، على أن عضوية الناتو مفتوحة لكافة الدول الأوروبية، وأن قرار الالتحاق منوط بحلف الناتو نفسه وليس الولايات المتحدة.
لم ينشر الروس ولا الأميركيون محتوى ردِّ إدارة بايدن على ورقة المطالب الروسية، ولكن ثمة تقارير تقول بأن أبعد ما ذهب إليه الأميركيون هو اقتراح ترتيبات أمنية احتياطية، من قبيل التنسيق العسكري وإقامة قنوات اتصال مبكرة في دول الناتو القريبة من روسيا، بين واشنطن وموسكو. وما فُهم من قراءة بوتين لمباحثاته مع الرئيس الفرنسي، ماكرون، في لقاء القمة الطويل الذي جمع بينهما في موسكو، أن القوى الغربية تقول: إن مسألة التحاق أوكرانيا بالناتو ليست مطروحة في المدى المنظور. ولكن هذا لا يعني، من وجهة نظر موسكو أن المسألة لن تُطرح في المستقبل.
بكلمة أخرى، ما طالب به الروس، على الأقل فيما يتعلق بأوكرانيا، كان ضمانات متواضعة بالتأكيد، وهي ضمانات سبق أن تقدم بها الأميركيون للرئيس غورباتشوف عشية توحيد ألمانيا، في 1991، ولكن الغرب نكث بها جميعًا واستمر في توسيع نطاق الناتو في دول حلف وارسو ودول الاتحاد السوفيتي السابقة. والأرجح، أن بوتين أمر قيادة جيشه مبكرًا بالاستعداد لغزو أوكرانيا، ولكنه كان يأمل في أن يدفع الحشد المعلن ورفع مستوى التوتر حول أوكرانيا إلى أن تستجيب الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى لمطالبه. والأرجح، أيضًا، أنه لم يتخذ قرار الحرب إلا بعد أن تيقن أنه لن يحقق ولو الحد الأدنى من هذه المطالب.
ما قامت به إدارة بايدن في المقابل كان الإعلان المتكرر عن اقتراب موعد الغزو، وإرسال مساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا، وتهديد روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية، والتأكيد في الوقت نفسه على أن لا الولايات المتحدة ولا دول الناتو الأخرى ستدفع بقواتها إلى أوكرانيا. بدا الموقف الأميركي، حتى إن لم يكن هذا هو الواقع، كأنه يتجنب تبني سياسة احتواء للروس، ويمتنع عن اتخاذ إجراءات كافية لردعهم، بل قد يشجعهم بالفعل على الغزو.
أما السؤال حول الدوافع خلف عدم الاكتراث بتداعي الأزمة نحو الحرب، فيبقى محل التخمينات. لم تُخْفِ الولايات المتحدة، مثلًا، حتى قبل تسلم بايدن مقاليد البيت الأبيض، قلقها من تزايد اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، وما يشبه احتضان القوى الأوروبية خلال السنوات العشر الماضية لروسيا ومحاولة دمجها في المجال الأوروبي، ماليًّا واقتصاديًّا على الأقل. والمؤكد أن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة هذه المخاوف. لكن اجتياح روسيا لأوكرانيا، لن يقيم حائطًا راسخًا بين روسيا ودول القارة الأوروبية الأخرى وحسب، بل وسينجم عنه عودة الاصطفاف الأوروبي خلف القيادة الأميركية، وتخفف تدريجي في اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، وخروج روسيا من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك مجلس التعاون الأوروبي، وتوجه أوروبي جديد نحو التسلح وزيادة الميزانيات الدفاعية.
بيد أن الحرب، من ناحية أخرى، لم تكن ضرورية لبوتين ولا لروسيا. مشروعية المطالب الروسية لا تعني أن الحرب كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيقها. خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت روسيا استعادة نفوذها في سوريا بدون تورط عسكري عميق، وتعزيز وجودها في القوقاز بعد أن اتخذت موقفًا متوازنًا من الحرب الأذرية-الأرمينية، وإحكام قبضتها على كازاخستان بعد وقوع ما يشبه الثورة الشعبية قصيرة العمر. في هذه الحالات، كما في أوكرانيا خلال السنوات بين 2004 و2014، لم تكن روسيا تحتاج الحرب لتحافظ على نفوذها ومصالحها. وليس ثمة شك في أن استعادة أوكرانيا كانت ممكنة بدون اللجوء إلى الحرب والغزو، سيما أن احتمال عضويتها في الناتو يظل ضئيلًا ومستبعدًا، طالما أن الدولة الأوكرانية تواجه مسألة سيادة على كافة أرضها؛ الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة لعضوية الحلف.
نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة
لا أحد يمكنه توقع ما ستتطور إليه هذه الحرب، ولا حتى القيادة الروسية ذاتها. في هذه المرة، تنطبق أيضًا القاعدة الكلاسيكية التي تقول: إن “كل مخطط للحرب ينهار مباشرة بعد الاشتباك الأول”. ولا أحد يعرف على وجه اليقين الأهداف الروسية الحقيقية من الحرب: هل يستهدف بوتين السيطرة على شرق وجنوب شرق أوكرانيا، قلب الصناعة الأوكرانية وطريق روسيا البري الآمن إلى شبه جزيرة القرم، وينتظر من ثم استسلام كييف أو سقوط نظامها الحاكم، أو أنه يسعى إلى دخول كييف واحتلال شامل لأوكرانيا؟
المؤكد أن الحرب في يومها الرابع لا تسير كما تصورتها القيادة الروسية: هذه لن تكون حربًا سريعة، ولا نظيفة، وحتى إن نجحت روسيا في النهاية في احتلال أوكرانيا، فإن تأمين السيطرة عليها يبدو بعيد المنال. قرار بوتين في 27 فبراير/شباط بوضع الترسانة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في مطلع الستينات، يشير إلى ضعف الموقف الروسي لا إلى قوة وثقة بالنفس.
ثمة اتفاق أوَّلي حول عقد مباحثات أوكرانية-روسية، على مستوى منخفض من المسؤولين، في مدينة بيلاروسية حدودية مع أوكرانيا، بدون شروط مسبقة. ولكن من الصعب تصور أن تصل هذه المباحثات إلى نتائج ملموسة في جولتها الأولى، وبدون مشاركة أميركية. كما أنه من غير الواضح ما إن كانت موسكو ستتراجع عن مطالبها المبكرة من أوكرانيا، التي تضمنت تسليم الجيش الأوكراني سلاحه، وتحييد أوكرانيا كليًّا.
برؤية أبعد قليلًا، ثمة عدد من المتغيرات التي يمكن توقعها، وبصورة أولية فقط، لما يمكن أن تفضي إليه هذه الحرب، على الصعيدين، الدولي وشرق الأوسطي:
إن استطاعت روسيا تحقيق انتصار سريع ونظيف، الأمر الذي أصبح محل تساؤل، فليس ثمة شك في أن بوتين سيذهب إلى ما هو أبعد من أوكرانيا، في سعيه لإقامة حزام آمن، تابع أو حيادي، في جوار روسيا الأوروبي والقوقازي والآسيوي. وسيجعل نجاحُ روسيا حلفاءَها شرق الأوسطيين، سيما في إيران وسوريا، أكثر جرأة، سواء في تحركات الأولى الإقليمية، أو سعي الثانية إلى بسط نفوذها على المزيد من الأرض السورية، وربما سيدفع نجاح بوتين في أوكرانيا إلى تشجيع الصين على اتخاذ خطوات أوسع نحو استعادة تايوان.
ولكن، وسواء نجحت المغامرة الروسية في أوكرانيا أو أخفقت، فإن عملية إدماج روسيا في المجال الأوروبي قد توقفت. تعود أوروبا إلى الانقسام من جديد، وإن على أساس خطوط تختلف إلى حدٍّ كبير عن حدود الحرب الباردة؛ حيث خسرت روسيا أغلب حليفاتها السابقات في حلف وارسو، وجمهورياتها الأوروبية السوفيتية السابقة، لصالح الناتو والاتحاد الأوروبي.
أوروبا هي بؤرة الحروب الأكبر في التاريخ الإنساني الحديث، والسلْم الذي عاشته القارة في العقود القليلة الماضية كان سلْمًا استثنائيًّا. ولكن، وبالرغم من أن هذه الأزمة الأوروبية هي الأكثر تعقيدًا منذ الحرب العالمية الثانية، فإن حلًّا تفاوضيًّا، يحفظ ماء وجه الطرفين، لم يزل ممكنًا.
إن لم يحدث التوصل إلى حل تفاوضي، فالأرجح أن الساحة الدولية ككلٍّ ستتحرك نحو تبلور ثلاث دوائر من النفوذ: روسية، وصينية، وأورو-أطلسية (على أساس أن من المبكر جدًّا توقع قيام تحالف روسي/صيني). ولكن الحدود الفاصلة بين هذه الدوائر ستظل مرنة نسبيًّا، نظرًا لمحاولة الأطراف المختلفة جذب حلفاء جدد. ولابد أن دول الشرق الأوسط المنتجة للطاقة، من قطر إلى الجزائر، ستعود لتحتل موقعًا أكثر أهمية في موازين القوى العالمية، خاصة إن بدأت دول أوروبا في التحرر من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية. كما ستستعيد تركيا ثقلها الاستراتيجي في منظور كافة أقطاب التدافع الدولي، طالما اعتمدت موقفًا متوازنًا من الصدام الروسي-الغربي، حتى مع حفاظها على التزاماتها في حلف الناتو.
من جهة أخرى، فإن كانت التوجهات الغربية نحو عزل روسيا أصبحت واضحة، فليس من الواضح كيف ستتطور السياسات الغربية، والأميركية منها على وجه الخصوص، من الصين، التي أصبحت مصدر قلق كبير للاستراتيجية الأميركية العالمية منذ تبنِّي أوباما سياسة المحور الآسيوي، والتي ترتبط بوشائج اقتصادية ومالية أعقد من روسيا بكثير مع القوى الغربية.
—————————
قرار تركيا إغلاق المضائق.. بداية صدام مع روسيا أم خطوة “دبلوماسية وسطية” تُجنبها الاصطفاف؟/ إسماعيل جمال
عقب أيام من التكهنات والضغوط والمداولات، وفي اليوم الخامس للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت تركيا، الإثنين، أنها تطبق أحاكم اتفاقية مونترو “بحذافيرها”، مؤكدة أنها أبلغت جميع الدول بأنها لن تسمح بعبور السفن الحربية من المضائق التركية، في خطوة تستهدف السفن الروسية بدرجة أساسية، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام التكهنات ما إن كانت هذه الخطوة سوف تفتح الباب أمام الصدام السياسي بين أنقرة وموسكو، أم أنها خطوة “دبلوماسية وسطية” تجنب أنقرة الاصطفاف وإغضاب أي من أطراف الصراع.
ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، ضغطت كييف على أنقرة عبر كافة القنوات الدبلوماسية من أجل إغلاق المضائق التركية أمام السفن والغواصات الحربية الروسية، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي مع أردوغان على “أهمية اتخاذ تركيا قرارا بإغلاق المضائق في هذا التوقيت”، وذلك بعدما قدم السفير الأوكراني في أنقرة طلباً رسمياً للخارجية التركية بهذا الخصوص.
وعلى مدى الأيام الماضية، اكتفى كبار المسؤولين الأتراك بالتأكيد على أن أنقرة تلتزم بتطبيق بنود اتفاقية مونترو التي تنظم عبور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وخاصة وقت الحرب، دون إظهار أي موقف يشير إلى نية أنقرة حظر مرور السفن الروسية، وذلك في إطار الخط الدبلوماسي الذي اتخذته تركيا منذ بداية الأزمة والقائم على عدم اتخاذ أي مواقف أو إجراءات يمكن أن تحسم وقوفها إلى جانب أحد طرفي النزاع، على الرغم من إجراءاتها غير المباشرة الداعمة بشكل واضح لأوكرانيا والإدانة الشديدة للغزو الروسي.
وكانت أنقرة قد تريّثت في الرد على مطلب كييف بالقول إن “خبراءها” يدرسون “ما إذا الحرب قائمة من وجهة نظر قانونية”، الأمر الذي يتيح لها تفعيل امتيازاتها بموجب الاتفاقية، قبل أن يعلن وزير الخارجية الأحد أن “الرد جاء إيجابيا وأن تركيا ستطبّق الاتفاقية بحذافيرها”.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضائق التركية. وقال عقب اجتماع للحكومة التركية ترأسه أردوغان: “اتفاقية مونترو تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفا في الحرب.. أما إذا لم تكن تركيا طرفا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها”.
وأضاف الوزير التركي: “أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا”، لكنه استدرك بالقول إن “الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود”، وتابع: “الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا؟ قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها”.
وإلى جانب تعمّد الوزير التركي الحديث عن قرار مباشر بمنع مرور السفن الروسية، فضل جاويش أوغلو الحديث عن “منع مرور جميع السفن للدول المشاطئة وغير المشاطئة” في محاولة لإظهار أن القرار يشمل جميع الدول، ولا يستهدف موسكو بشكل مباشر، ويمنع روسيا من اعتبر الخطوة التركية “عدائية وموجهة ضدها”.
وفي المرحلة الحالية، وعلى الرغم من أن القرار العام يشمل جميع الأطراف، فإنه يستهدف السفن الروسية بشكل مباشر التي تعتبر الأكثر احتياجاً للعبور من المضائق التركية، إلا أن اتفاقية مونترو في الوقت نفسه تتيح لروسيا مخرجاً مهماً، كونها تنص على أن الدولة من حقها إعادة سفن أسطول البحر الأسود إلى قواعدها، وهو ما يتيح لروسيا الحفاظ على إعادة سفن أسطول البحر الأسود إلى موانئها هناك.
كما أن القرار التركي وعلى الرغم من أنه يستهدف روسيا بدرجة أساسية في المرحلة الحالية، إلا أنه يقدم ضمانات لموسكو أيضاً، حيث شمل منع مرور كافة سفن الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود، وهو ما يعني ضمان عدم وصول دعم عسكري غربي لأوكرانيا عن طريق البحر، أو مرور سفن حربية للناتو إلى البحر الأسود أيضاً.
ولا يتوقع أن تؤدي الخطوة التركية الحالية إلى أي موقف من أطراف النزاع أو داعميه، حيث لن تعتبر روسيا الخطوة التركية “عدائية وتستهدفها بشكل مباشر”، كما أنها ستكون مرضية لأوكرانيا والناتو، الذي سيعتبر أن أنقرة اتخذت ما يتوجب عليها في دعم مطالب الحكومة الأوكرانية، وهو ما يصب جميعه حتى الآن في خدمة الاستراتيجية التركية القائمة على عدم اعتبارها طرفا في الأزمة، حيث تواصل مساعيها للعب دور الوسيط رغم استعار الحرب.
وعقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، الإثنين، أكد أردوغان أن تركيا “عازمة على استخدام صلاحياتها النابعة من اتفاقية مونترو بخصوص عبور السفن من المضائق، بشكل يحول دون تصعيد الأزمة”، مضيفاً: “لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية. لذلك نقول إننا لن نتخلى لا عن أوكرانيا ولا عن روسيا”، مجدداً تأكيده موقف تركيا الداعم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
واعتبر أردوغان أن تركيا “أوفت بمسؤولياتها حرفيا حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها، وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي”، مضيفاً: “لا يساور أحد الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود (الهجوم الروسي على أوكرانيا) على غرار التحديات السابقة”، كاشفا عن أن بلاده تواصل مبادراتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.
من جهته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل تطبيق البنود 19 و20 و21 من اتفاقية مونترو للمضائق البحرية، مبيناً أن تآكل الاتفاقية “لن يعود بالفائدة على أحد”، وشدد على “ضرورة الحفاظ على مضمون وأحكام اتفاقية مونترو، لأن إثارة الجدل حولها أو تآكلها لن يعود بالفائدة على أحد”.
القدس العربي
————————-

بوتين يُجرَّد من حزامه الأسود/ رشا الأطرش
بالرياضة والفنون، بالإعلام ومنصات السوشال ميديا، تهوي قبضات القوى الناعمة الغربية والعالمية على رأس فلاديمير بوتين عقاباً له على غزو أوكرانيا. العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، أساس. لكن الرجل الذي لطالما تصدرت صوره “الهرقلية” الروزنامة السنوية المطبوعة على ورق لامع، في بداية كل عام، مدرك تماماً لقدرات القوى الناعمة، بل مهجوس بها، لا سيما الرياضة، في تحريك الرأي العام ومهر الهوية الوطنية والسيادة، ورسم صورة جبارة حيوية وعابرة للحدود عن “روسيا بوتين”، بما يفوق الأسلحة التي أثبتت تقادمها في هذه الحرب، والتراكيب الاستثمارية والاقتصادية المشوبة غالباً بالفساد والجريمة المنظّمة. بوتين يعشق صورته، صورته “المصارعجية” هذه بالتحديد، ولطالما سعى لجعلها، مع ملامح الأمّة الروسية المعاصرة، وجهين لروبل واحد، داخلياً وخارجياً.
هو صاحب حزام الجودو الأسود، الحريص على التباهي بعُريّ صدره القوي. الرئيس الفخري لاتحاد الجودو الدولي (وقد تمت تنحيته من هذا المنصب). “بطل” ركوب الخيل وصيد الأسماك والغطس في حمّامات الجليد. مشجع هوكي الجليد، والمُثابر على دعمه بحدث سنوي حيث يلتقي مع بعض أفضل لاعبي البلاد الذين سمحوا له بالتزلج معهم وسحق القرص في الشبكة. مهووس هو بتكريس صورته كقائد عضليّ أيضاً، وكزعيم أكثر نجومية من زعماء العالم الديموقراطي. هذا البوتين هو الذي قال، عندما كان الرياضيون الروس غارقين في فضيحة منشطات العام 2016: “يجب ألا تتدخل السياسة في الرياضة”، ولا أن تكون “أداة للضغط الجيوسياسي”. اليوم يشعر بوطأة الرياضة المسيّسة، وقد انقلب سحرها على شعوذته. الرياضة المسيّسة، كما يجب أن تكون، شأنها شأن الثقافة والإعلام وحتى البزنس…
قضايا كثيرة لمست، تاريخياً، تأثير القوة الناعمة في مناصرتها، من فلسطين إلى جنوب إفريقيا. حتى الاتحاد السوفياتي السابق حاول الاستفادة من تأثير السينما والرقص والأدب والموسيقى والرياضة لتجميل وكتم ما يجري خلف أسواره الحديدية، وأحياناً، بالعكس كان طوق نجاة خطيراً لرعاياه الذين يحاولون الهرب إلى الغرب مع فرقة باليه تقدم عرضاً في الخارج، فتهرب راقصة وتختفي، أو يُعاد فنان بالقوة إلى “حضن الوطن”.
الشعب الروسي اليوم يجد نفسه في عزلة مشابهة لتلك التي عاناها خلال الحرب الباردة قبل أكثر من نصف قرن. وما عادت نافعة، لا البروباغندا، ولا حملات “الترولز” والمعلومات المضللة. فمن أجل أن تنجح بلطجة القوة الناعمة، يجب أن تكون موصولة بالتمديدات العالمية، الافتراضية والثقافية، السياسية والاقتصادية. وروسيا الناعمة، اليوم، سقطت من الشبكة، لتوشك على الغرق في ظلام دامس لا شك أنه يُغضب بوتين المجنون بالظهور من دون أن يكترث للثمن الذي يدفعه وسيدفعه شعبه جراء بتر البلاد من الجسم الدولي.
فقدت سانت بطرسبرغ الحق في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأُلغي سباق “الجائزة الكبرى” (فورمولا) الروسي. انضم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى الاتحادات الأوروبية لكرة القدم ليعلن أنه سيمنع الفرق الروسية من المشاركة في فاعلياته، لا سيما كأس العالم 2022 المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في قطر، حتى إشعار آخر. “الفيفا” نفسه الذي قال رئيسه، جياني إنفانتينو، عشية استضافة روسيا لكأس العالم 2018: “لا ترسم بالطلاء الداكن كل شيء يأتي من الشرق”، ولم يكد يمرّ عام على الحدث حتى عاد إنفانتينو إلى موسكو لتسلم ميدالية الدولة من بوتين، مصرّحاً بأن “العالم أنشأ روابط صداقة مع روسيا ستستمر إلى الأبد”.. وهذا الأبد انتهى يوم الخميس الماضي عندما أمر بوتين قواته بدخول أوكرانيا.
بدورها أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بمنع الفرق الروسية من المشاركة في المسابقات، داعية الاتحادات الرياضية لإلغاء كل نشاط في روسيا التي انتهكت “الهدنة الأولمبية”. علماً أن بوتين كان أحد قادة العالم القلائل الذين حضروا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في بكين مؤخراً، وفي أجندته الكثير ليبحثه مع الرئيس الصيني في كواليس الحلبات البيضاء المزدانة بأعلام العالم، وعلى رأسها أوكرانيا وتايوان.
ألغت دار الأوبرا المَلَكية، في لندن، موسم عروض لفرقة “باليه بولشوي” الروسية الشهيرة. وسيتم استبعاد روسيا من مسابقة “يوروفيجن” للأغنية هذا العام، إذ قال المنظمون إن مشاركتها قد “تؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة”. واستجابت كبرى شركات الإنتاج والبث مثل “ديزني” و”سوني” و”وارنر بروس” و”نتفليكس” لنداءات “أكاديمية السينما الأوكرانية” و”وكالة السينما الأوكرانية الحكومية” إلى مجتمع السينما في العالم والمهرجانات الدولية من أجل مقاطعة السينما الروسية ومؤسساتها وفرض عقوبات على صناعتها. كما تعرضت مجموعة كبيرة من الشركات الروسية من مختلف القطاعات لاستقالات من كبار المديرين الأوروبيين، وهم الذين كانوا جزءاً من الأدوات الروسية لاكتساب النفوذ بين النخب في الغرب.
بوتين، “شخصية العام” 2007 في مجلة “تايم” الأميركية، و”الشخص الأكثر نفوذاً” للعام 2013 في مجلة “فوربس”، يحترق في عتمة قسرية. روسيا بوتين تفقد الترحيب الذي أنفقت مليارات الروبلات لتحظى به (أو بإيحائه) في المجتمع الغربي، وهذا ليس بالقليل.
لماذا لم يحصل ذلك لدى انخراطها في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد، لتصبح احتلالاً للأرض والشعب والمقدرات السورية؟ لماذا لم تُعاقَب، ومعها صديقتها (المُحرَجة راهناً) إسرائيل، على احتلالات واستعمارات وانتهاكات كبرى في حق فلسطينيين وعرب؟ لماذا لم يقاطع العالم مستبدي العرب من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كما يقاطع الآن بوتين؟ إجابات عديدة ومفصلة متوافرة في الجغرافيا والتاريخ، في خرائط الطاقة والرسوم التوضيحية لعلاقات الدول وتشابك مصالحها. لا أحد يزعم إنصافاً جوهرياً في حركة القوة، لا الناعمة ولا الصلبة. لكن الصفعة الثقافية التي يتلقاها فلاديمير الآن تستحق الاحتفاء بحزام حريري ملوّن يفتّت حزامه الأسود.
المدن
————————–
نيويورك تايمز: بعد النكسات الأولى لغزوهم لأوكرانيا عاد الروس لأساليبهم والأيام القادمة حاسمة
إبراهيم درويش
تحت عنوان “بعد بداية خادعة، بدأت القوات الروسية الضرب بقوة في أوكرانيا” نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده ستيفن إرلانغر قال فيه إن القوات الروسية وبعد سوء تقدير حول عزيمة الأوكرانيين القتالية انتقلت إلى أشكال القتال التي تعرفها وهي قصف المدن وحصارها. وأضاف أن المراقبين، وفلاديمير بوتين، توقعوا عندما شنت روسيا غزوا على أوكرانيا بمشاركة حوالي 200.000 جندي أن تزحف القوات بسرعة وينتهي القتال.
وما ظهر بعد خمسة أيام هو سوء تقدير الروس حول أساليبهم وكيفية رد الاوكرانيين. ويضيف أنه لم تسقط أي مدينة بالكامل في الدفعة الأولى للروس نحو كييف التي توقف عندها تقدمهم. وفي نفس الوقت جمع الأوكرانيون قواهم وسلحوا المدنيين وهاجم الجيش الأوكراني قوافل الروس وخطوط الإمداد حيث تركوا أدلة فيديو عن عربات روسية محروقة وجثثا للجنود. إلا أن الحرب تغيرت بسرعة يوم الإثنين وستشير إلى المدى الذي ستذهب فيه روسيا لإخضاع أوكرانيا.
وبحسب السجل الروسي في سوريا وحملتها لسحق الإنفصاليين الشيشان تقترح حملة وحشية قادمة. وظهرت الإشارات في المدينة الثانية بأوكرانيا خاركيف عندما سرعت روسيا من عمليات القصف على الأحياء المدنية مخلفة وراءها ضحايا مدنيين وربما استخدمت القوات الروسية فيها قنابل عنقودية التي تمنعها كل الدول باستثناء روسيا وأوكرانيا. وقال السفير والجنرال الأمريكي السابق لدى الناتو دوغلاس لوت ” نحن في الأيام الأولى من هذه الحرب، ولدى بوتين الكثير من الأوراق لكي يلعبها”و “من الباكر لأوانه الحديث بلهجة انتصارية وهناك الكثير من القدرات الروسية التي لم تنشر بعد”. وتعتبر العقيدة القتالية الروسية للسيطرة على المدن قاتلة وقاتمة وعملية. وتقوم على القصف المدفعي والصواريخ والقنابل والقنابل التي تخيف المدنيين وتدفعهم للهروب وتقتل المدافعين وتدمر البنى التحتية قبل التقدم بريا. وقال لوت إن روسيا لم تحشد كل قدراتها العسكرية بطريقة فعالة بعد. و “لكن العقيدة الروسية في القصف المكثف وعدم المقيد كانت واضحة في الشيشان وهناك احتمال بأن تعيد روسيا تجميع قدراتها من الناحية التكتيكية وقد يؤدي إلى قصف مكثف ضد المراكز المدنية”.
ويقول مسؤول أمريكي في البنتاغون إن القوات المتقدمة نحو كييف تواجه مقاومة “فعالية وإبداعية”، ولكن الحملة العسكرية في يومها الخامس وسيتعلم القادة الروس من أخطائهم ويتكيفون مع الأوضاع كما فعلوا في سوريا. وقال المسؤول إن هناك مخاوف من تصعيد الروس لعمليات القصف الجوي والصواريخ على المدن مما سيؤدي إلى ضحايا بين المدنيين. ويرى عدد من الخبراء أن بوتين أساء التقدير على ما يبدو أن هجوما سريعا على كييف سيطيح بالرئيس فولدومير زيلنسكي في ظل عدم اهتمام الأوكرانيين. وهذا ما يفسر قرار الروس الدخول بشكل مخفف للحد من الضحايا المدنيين. ولكن رد فعل الأوكرانيين فاجأ الروس وفشلت محاولتهم للسيطرة على مطار في كييف من أجل وصول التعزيزات. وقال ماثيو بولغيو، الخبير في الحروب الروسية بشتام هاوس في لندن إن الروس أبدوا تحفظا في استخدام القوة في الأيام الأولى “يدفعون ثمن خطابهم من أن هذه حرب دفاعية ضد فاشيين ونازيين جدد” و “لكننا أغضبنا الكرملين ولم نر بعد ما يخبئه لنا الروس”. وقال إن العالم “بدأ بمتابعة المرحلة الثانية عندما تبدأ الدبابات الثقيلة والقوات البرية كما يفعلون في خاركيف وماريبول”. وأضاف “ما أخشاه أن هذه هي البداية” وسنرى “غزوا متمما بقوات مجربة وجنود أكثر وعدد قليل من أنظمة التحكم الدقيقة وحرب استنزاف وقصف سجادي ومزيدا من الضحايا”. وقال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في معهد البحث “سي أن إي” أن محاولة الروس السيطرة على كييف وبناء على افتراض قاصر عن أوكرانيا، لم يستخدم الروس معظم قدراتهم القتالية وتلقوا ضربة في الأيام الأولى من الحرب. و “لكننا لا نزال في الأيام الأولى من الحرب وانتهت نشوة الساعات الـ 90 الأولى بشكل يكذب ما يجري على الواقع وأن القادم قد يكون أسوأ”. ويقول جاك وولتينغ، الخبير في الحروب البرية بالمعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن وعاد من أوكرانيا قبل 12 يوما ويتوقع مزيدا من الضغط الروسي في الأيام المقبلة “لدى الروس الكثير من القوات في أوكرانيا ويواصلون التقدم بثبات ويمكنهم العمل بطريقة مشتركة وليس كقوافل دبابات معزولة ولديهم القدرة على استخدام مستويات عالية من القوة”. ويتوقع الخبراء قيام القوات الروسية بتوسيع سيطرتها على المناطق المؤيدة لروسيا في دوينتسك ودونياس، شرق أوكرانيا ومن ثم السيطرة على الجسر إلى القرم في الجنوب في وقت يدفعون فيه قواتهم من الشمال لمحاصرة الجيش الأوكراني الرئيسي شرقي نهر دونبير. وهم يحاولون حصار ماريبول وخاركيف. وسيؤدي الحصار لعزل الجزء الأكبر من القوات الأوكرانية عن كييف والحصول على الإمدادات، وبشكل سيحد من ديمومة المقاومة. ويتحرك الروس نحو كييف من اتجاهات ثلاثة لمحاصرتها.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الروس مشكلة إمدادات ولوجستية كما في الأيام الأولى وتوقف العربات بدون وقود إلا أن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل أعقد. وسيعاني من نقص في صواريخ ستينغر وجافلين في مدى أسبوع. وتقوم الدول الأعضاء في الناتو بتزويد الأوكرانيين بالذخيرة عبر بولندا، عضو الناتو والتي لا تزال حدودها مع غرب أوكرانيا مفتوحة، بل ووعد الناتو الإتحاد الأوروبي بتقديم 450 مليون يورو لشراء السلاح وتوصيله للأوكرانيين. إلا أن المساعدات هذه لن تجدي لو عزل الروس المدن. وبدأت المروحيات الروسية بالتحليق قرب الحدود البولندية وستتحرك قوات من بيلاروسيا لقطع خطوط الإمدادات القادمة من بولندا، وبخاصة لو دخلت القوات البيلاروسية الحرب، وهو أمر محتمل.
ولم تمنع البدايات السيئة روسيا عن الإنتصار في حروب سابقة ولكن بثمن باهظ. وفي سوريا تعرض الروس لنكسات مما أثار التكهنات حول مستنقع أفغاني ولكن على البحر المتوسط. ولكنهم تكيفوا مع الوضع واعتمدوا على القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في وقت عمل فيه حلفاؤهم على الأرض. وقدر عدد القتلى جراء القصف الروسي في الفترة ما بين 2015- 2017 بحوالي 5.700 مدنيا، ربعهم من الأطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت الحرب في الشيشان وحشية ودمرت العاصمة غروزني. وساعدت على منح بوتين، رئيس الوزراء الجديد صورة الرجل القوي. ومات الألاف قبل سيطرة روسيا على الوضع ونصبت موسكو نظاما عميلا لها هناك. وقال وولتينغ أن الروس حتى هذا الوقت مارسوا ضبط النفس في قصف أوكرانيا على اعتقاد أنهم لا يستطيعون تحويل كييف إلى غروزني ثم حكمها و “لكننا نرى الكرميلن قد صادق على عنف شديد بدء من خاركيف” وعلى قصف للمناطق المدني. وهناك قصف مماثل في كييف وتشرينف، الواقعة شمال- شرق العاصمة.
وعلق وولتينغ أنه “لا يمكنك إخضاع السكان بهذه الطريقة وتفتح الباب أمام المقاومة”. إلا أن هذه الإستراتيجية تطرح أسئلة أخلاقية بين الجيش والرأي العام الروسي. وقال إيان بوند، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي “الكثير يعتمد على الوحشية التي سيمضي فيها الروس” و يضيف أنه “لا يمكنك فرض الرقابة على كل شيء واستخدام الوحشية ضد الأوكرانيين الذي يرتبط الكثير من الروس بروابط معهم لن يكون ناجحا سياسيا لبوتين”. ويواجه بوتين معارضة للحرب في الداخل.
القدس العربي
————————-

أوكرانيا بعد أسبوع على الغزو: حصيلة روسية عجفاء
الاجتياح الروسي في أوكرانيا يدخل غداً يومه السابع وتتكاثر تباعاً المؤشرات التي تؤكد أن الحصيلة تسير على نقيض الخطط التي أعلنها الرئيس الروسي بصدد «عملية محدودة» كما أنها تكذّب أكثر فأكثر المزاعم التي ساقتها القيادة الروسية في تبرير الغزو، خاصة تلك التي تتهم القيادة الأوكرانية بانتهاج سياسة نازية ضد الشعب الأوكراني بأسره.
وقد تكون المظاهر المختلفة للمقاومة الشعبية المباشرة ضد الاجتياح الروسي هي أولى المؤشرات على نقائض التصريحات وأكاذيب النوايا من الجانب الروسي، رغم أن قدرات الجيش الأوكراني لا يمكن أن تُقاس بما تمتلكه قوّة نووية عظمى مثل روسيا، وأن أشكال المقاومة الشعبية تظل عفوية ومنخفضة السلاح والتدريب. ولا يغير من الجوهر أن الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي سارعت إلى تزويد أوكرانيا بصنوف متطورة من الأسلحة، فالأصل هنا يعود إلى روحية رفض الاجتياح لدى أبناء أوكرانيا.
في المقابل لا يلوح أن العمليات العسكرية على الأرض تسير كما خططت لها القيادة العسكرية الروسية، بل على العكس يبدو الإحباط هو الشعور السائد إزاء نتائج تعتبر هزيلة بعد ستة أيام على بدء الاجتياح، حتى أن السؤال بات يدور اليوم حول الفشل في إنجاز هذا أو ذاك من الأغراض الكبرى خلف العمليات العسكرية. وإلى جانب تأثيراته السلبية المباشرة على معنويات أفراد الجيش الروسي، فإن اليأس من تحقيق انتصارات حاسمة يمكن أن يدفع هذا الجيش إلى حافة اليأس واعتماد ضربات وحشية عشوائية تتقصد رفع المعنويات وتنطوي استطراداً على ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب.
وليس من المؤكد أن بوتين ومستشاريه والحلقة الضيقة القريبة منه، وقسطا غير قليل منها تشغله أوليغارشيات مالية على صلة بالمافيات الداخلية والخارجية، كانوا قد تحسبوا لطراز من العقوبات الأمريكية والغربية يمكن أن يشتمل على إزالة مصارف روسية بارزة من نظام المدفوعات العالمي «سويفت» الذي يصعب أن تستغني عنه التجارة الروسية مع العالم الخارجي، وسبق لوزير المالية الفرنسي أن اعتبره بمثابة سلاح نووي. ليس واضحاً كذلك أنهم توقعوا هبوط الروبل أمام الدولار بأكثر من 41٪ خلال أقلّ من أسبوع على بدء الاجتياح، وهذا رقم قياسي يُضاف اصلاً إلى معدل الـ 53.77٪ التي خسرها الروبل مؤخراً في أسواق الصرف.
وكانت تقارير صحافية قد اشارت إلى أن بوتين راهن على تردد ألمانيا، سواء بخصوص تجميد مشروع خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2» أو بصدد حزمة العقوبات الاقتصادية الأقسى ومن ضمنها تجميد أصول المصرف المركزي الروسي وإخراج بعض المصارف الروسية من نظام الـ»سويفت». فإذا صحت تلك التقارير فإن حسابات بوتين لم تكن خاطئة فقط، بل كانت غافلة تماماً عن احتمال أن تذهب ألمانيا إلى إجراءات أبعد، مثل تخصيص 100 مليار يورو للاستثمارات العسكرية، مما يعني أن بوتين قد يكون المتسبب في دفع الجيش الألماني إلى الاستيقاظ من سبات ذاتي قسري.
حصيلة عجفاء، إذن، كما تقول مؤشرات أخرى عديدة. ولعل القادم على مغامرة بوتين في أوكرانيا سوف يكون أعظم
القدس العربي
———————-
بوتين: هل من مجنون يلوح بالسلاح النووي؟/ بسام مقداد
قال بوتين يوماً بأنه يأمل بألا يرى في يوم من الأيام شخصاً مجنوناً يجرؤ على إستخدام السلاح النووي. وأضاف حينها مؤكداً بأن روسيا ستواصل تطوير السلاح النووي كعامل ردع وضمان الأمن “لكن نحن لم نلوح يوماً ولن نلوح بهذه العصا النووية”. فهل كان يتخيل، حين قال هذا الكلام العام 2015 في الفيلم الوثائقي الروسي “النظام العالمي”، بأنه سيكون بعد سبع سنوات الشخص الذي يلوح بالسلاح النووي ويضعه في حالة الجهوزية القصوى ليوم القيامة، حسب صحيفة Mk وسواها في ذلك الحين.
من حق البشرية أن تسأل، وهي مهددة بالقيامة التي لا من يَسأل ولا من يُسأل بعدها، عن أسباب بوتين لدعوتها إلى رحلة فنائها هذه. ويؤكد هذا الإفتراض الفيديو الذي إنتشر بعد إحتماع نخبة الكرملين للبصم على قرار سيدها غزو أوكرانيا، ويظهر فيه مسؤول المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين يقف متلعثماً بين يدي بوتين الذي أمره بالجلوس بعد إنتزاع موافقته على قرار الغزو. وألحق بوتين غزوه بقرار الهيئة الفدرالية للإشراف على الإعلام Roskomnadzor حظر إستخدام كلمة حرب واستبدالها بتعبير “العملية العسكرية الخاصة” في الحديث عن الكارثة الأوكرانية، مما جعل صحيفة Novaya المعارضة تشكو من صعوبة إصدار عددها أمس الإثنين المخصص كله للحرب، لكن من دون ذكر كلمة حرب.
بغض النظر عن السبب المباشر الذي دفع بوتين للرقص على حافة القيامة، سواء كان إعلان رئيسة اللجنة الأوروبية اورسولا فاندر لاين عن إغلاق نظام SWIFT بوجه عدد من البنوك الروسية، أو إصطدامه بمقاومة أوكرانية جعلت حلمه كابوساً باجتياح كييف خلال 72 ساعة، إلا أن الواقعة وقعت على روسيا. المساعدات الغربية المالية والغذائية تتدفق على أوكرانيا، ولأول مرة يفتح الناتو لها مخازن أسلحته ويعد ببحث إنضمامها إليه، ومن أجلها فاجأت ألمانيا العالم بتخليها عن عقدة الذنب التي رافقتها منذ العام 1945 ، وقررت العودة لبناء آلتها العسكرية بوجه تهديدات بوتين، والدول المجاورة تستقبل بسرور الأوكران الفارين من الحرب. أما روسيا بوتين فأطبقت عليها عزلة لم تعرفها أيام الإتحاد السوفياتي، وتحولت إلى دولة منبوذة في العالم تطرد جامعات أوروبية طلابها، ويحظر طيرانها في أوروبا، وتشطب مصارفها من نظام التداول المالي العالمي. وحتى الصين التي “تفهمت هواجسها الأمنية” لم تصوت معها في مجلس الأمن الدولي أمس، وبقي إلى جانبها أصدقاؤها في بيلاروسيا وسوريا وإيران وفنزويلا ونيكاراغوا.
السبت المنصرم قفز السعر الرسمي للدولار من 77 روبلا قبل الغزو إلى 83، وتراوح بين 120 و150 روبلاً في السوق السوداء، حسب مصادر “المدن” في موسكو. وقبل ظهر أمس الإثنين تم التداول بالدولار في السوق السوداء بسعر 120 والرسمي 100 روبل (119 روبلاً حسب رويترز)، وكان سقف سحوبات الدولار من البنك للأفراد يتراوح بين130 و180 دولاراً، حسب المصدر عينه.
طرحت “المدن” سؤالين على المتابع لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة NG الروسية إيغور سوبوتين. أجاب بالنفي على السؤال بشأن ما أشيع عن حظر الإعلاميين الروس التواصل مهنياً مع أي موقع إعلامي أجنبي بشأن الحرب على أوكرانيا.
وعن السؤال بشأن تلويح بوتين بالسلاح النووي، قال سوبوتين بأن التهديد باستخدام السلاح النووي برز بشكل طبيعي في سياق تطور الأحداث السريع. وكلما طال أمد الهجوم الروسي، كلما تصاعدت نبرة خطاب الطرفين، وارتفع الإهتمام المحتمل بأدوات الضغط على الطرف المعادي.
ويقول بأنه لا يعتقد أن روسيا قادرة على إستخدام السلاح النووي. فالتصريح المعني للكرملين يبدو وكأنه تحذير للغرب بضرورة البقاء بعيدا عن العمليات الحربية، لأن تدخل الولايات المتحدة أو البلدان الغربية الأخرى لن يتيح الفرصة لموسكو تنفيذ مهماتها العسكرية. لكن الإشارة من بوتين في الظروف الراهنة سوف تؤخذ على محمل الجد، “وهذا ما يبتغيه الزعيم”.
موقع nachedeu الأوكراني نشر في 25 الجاري نصاً بعنوان “روسيا تهاجم أوكرانيا: بوتين يلوح الترسانة النووية”. يقول الموقع بأنه مر زمن طويل منذ أن لوح زعيم عالمي بهذا الشكل المكشوف بالتهديد بإستخدام السلاح النووي، لكن بوتين فعلها بقوله أن لديه سلاحاً رهيباً في حال تجرأ أحد ما على إستخدام الوسائل العسكرية لمحاولة وقف إحتلال روسيا لأوكرانيا.
كان من الممكن أن يكون التهديد فارغاً أو مجرد تكشيرة من الرئيس الروسي، لكن الكل توقف عنده. وأثار هذا رؤى عن نتيجة مروعة لطموحات بوتين في أوكرانيا التي يمكن أن تفضي إلى حرب نووية نتيجة صدفة أو خطأ في التقدير.
يستشهد الموقع بمقطع من كلمة بوتين للشعب الروسي التي أعلن فيها بدء غزو أوكرانيا، وذَكّر بكون روسيا إحدى أقوى الدول النووية، وحذر اي معتد عليها بعواقب وخيمة. ورأى الموقع أن بوتين أدخل في اللعبة إحتمال أن تؤدي العمليات العسكرية الحالية في أوكرانيا إلى مواجهة نووية بين روسيا والولايات المتحدة.
ويقول الموقع بأن هذا السيناريو المروع مألوف لأولئك الذين نشأوا خلال الحرب الباردة، وهي حقبة كان فيها تلاميذ المدارس الأمريكية يختبئون تحت الطاولات حين تطلق صفارات الإنذار النووية. لكن هذا الخطر تلاشى تدريجياً من الخيال العام بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي، وباتت القوتان تتجهان نحو نزع السلاح والديمقراطية والازدهار.
المؤرخ الروسي الكبير أندريه زوبوف نشر في الأسبوعية الأوكرانية NV في 27 المنصرم نصاً بعنوان “إبتزاز بوتين النووي. كيف سينتهي كل هذا”، وأرفقه بآخر ثانوي “من الواضح أن بوتين لم يتمكن من إحراز أي نجاح في أوكرانيا بالسلاح التقليدي”. يقول المؤرخ أن بوتين اصدر أمراً بفرض السيطرة بأي ثمن على مدينتي كييف وخاركوف، لكن الأمر لم ينفذ ولا يزال العلم الأوكراني يرفرف فوق المدينتين. لافروف صرح بأن لا محادثات مع “الطغمة” الحاكمة في كييف قبل الإستسلام، إلا أنهم ذهبوا إلى المفاوضات دون اية شروط مسبقة. ويستنتج زوبوف بأن هذا يعني أن الأمور في ساحة المعركة وفي الكرملين تسير من سيئ إلى أسوأ.
وبينما ينتظر نتائج المفاوضات مع الأوكرانيين، رفع بوتين الرهان وأخذ يهدد الغرب مجتمعاً بضربة نووية من القوات الإستراتيجية الروسية، أي بالحرب العالمية الثالثة وفناء الحياة على الأرض. وكل هذا من أجل طموحاته المجنونة في إحياء الإتحاد السوفياتي والحؤول دون نزع الشيوعية. ومن المؤكد أن الغرب لن يسمح بترهيبه، لأن أي تنازل للمجنون يعني أمرا واحداً: بعد أوكرانيا ستكون كازخستان، ومن ثم أذربيجان، أرمينيا، مولدافيا وتتبعها بلدان البلطيق، وهكذا دواليك.
الرئيس الأميركي جو بايدن وضع قوات الولايات المتحدة الإسراتيجية في حالة الجهوزية رقم 2، كما فعل يوما ما جون كيندي أثناء الأزمة الكوبية خريف العام 1962.
ويقول زوبوف بأن المعتدي واضح للجميع، ولن يصبح بعد الآن شخصاً مرغوباً به في المجتمع الدولي. بوتين حول نفسه بأعماله المجنونة إلى جثة سياسية، والغرب حازم وموحد، وليس من بديل آخر للحرب النووية سوى إستبدال نخبة بوتين بأخرى مقبولة من العالم وقادرة على خفض توتر الصراع بالتعاون مع الغرب.
ويرى المؤرخ أنه، سواء بإرادته أو ضده، إلا أن ساعة بوتين قد حلت وعليه أن يتخلى عن سلطته بإسم روسيا. وإلا فإن العالم بأسره، وبالدرجة الأولى روسيا، مهدد جدياً ب”الموت المحتم”.
المدن
———————————

نتائج عكسية للغزو الروسي لأوكرانيا..فنلندا والسويد أقرب للناتو
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا خلال أيام قليلة بفنلندا والسويد للانتقال من سياسة عدم انحياز إلى حقبة جديدة مع إرسال شحنات “غير مسبوقة” من الأسلحة وانتشار تأييد قوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في صفوف الرأي العام.
واستبعدت استوكهولم وهلسنكي حتى الآن فرضية طلب الانضمام بصورة عاجلة إلى حلف شمال الأطلسي، لكن لم تكن الدولتان يوما قريبتين كما هما الآن من اتّخاذ هذه الخطوة، بحسب المحللين.
ويرى زيبولون كارلاندر، المحلل من منظمة “فولك اوك فورسفار” (المجتمع والدفاع)، أن “كل شيء ممكن في الوقت الحالي، وثمة إشارة من دول حلف شمال الأطلسي بأن درس انضمام فنلندا والسويد يمكن أن يحصل سريعاً، لذا أعتقد أن ذلك رهن بقرار سياسي من استوكهولم وهلسنكي”.
السويد وفنلندا هما من دول عدم الانحياز رسمياً إلا أنهم شريكتان لحلف شمال الأطلسي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما طوتا صفحة حيادهما في نهاية الحرب الباردة.
وناقش البرلمان الفنلندي بعد ظهر الثلاثاء، عريضة تدعو إلى إجراء استفتاء على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وجمعت العريضة في أقل من أسبوع 50 ألف توقيع لازم لموافقة البرلمان الفنلندي.
ومع أن رئيسة مجلس الوزراء الديموقراطية الاجتماعية سانا مارين التي بادرت إلى هذا النقاش البرلماني العاجل، تشدد على أن الأمر لا يتعلق بنقاش عام حول انضمام فنلندا إلى الناتو أو عدم الانضمام، إلّا أن الظروف السياسية تغيّرت فجأة.
وأظهر استطلاع نُشر الاثنين للمرة الأولى أن 53 في المئة من الفنلنديين يؤيدون الانضمام إلى التحالف العسكري. وتضاعف عدد المؤيدين للانضمام في غضون أسابيع قليلة فقط، فكان عددهم في كانون الثاني/يناير 28 في المئة فقط.
ويقول الباحث في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية شارلي سالونيوس-باستيرناك لوكالة “فرانس برس”، إن نتيجة الاستطلاع “تاريخية واستثنائية”، متوقعاً أن تبقى نسبة التأييد عالية بشكل مستدام.
وفي السويد أيضاً، لم يصل أبداً مستوى تأييد الرأي العام لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي إلى المستوى العالي الذي بلغه الآن. فوصلت نسبة التأييد بين السويديين إلى 41 في المئة في مقابل معارضة 35 في المئة فيما لم يتخذ 24 في المئة موقفاً، بحسب استطلاع أجراه معهد “نوفوس” وبث نتائجه الجمعة التلفزيون الوطني “سفيريجيس تلفزيون”.
تحذيرات روسية
وكسرت كلّ من فنلندا والسويد أحد المحرّمات الرئيسية في سياستهما الأمنية، وهو عدم تصدير أسلحة أو معدات عسكرية إلى دول في حالة حرب.
فقد قررت السويد إرسال، بالإضافة إلى المعدّات الوقائية (الخوذ والسترات الواقية من الرصاص وحصص غذائية)، نحو خمسة آلاف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، حسبما أفادت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون، وذلك للمرة الأولى منذ حرب الشتاء في العام 1939، عندما قدمت ستوكهولم المساعدة لجارتها الفنلندية التي غزاها الاتحاد السوفياتي.
وقال كارلاندر: “أظن أن هذا ليس إلّا بداية إعادة تقييم السياسة الأمنية السويدية. وثمة نقاش قائم أيضاً حول الاجراءات التي يجب اتّخاذها لتعزيز الجيش السويدي”.
وفي “قرار تاريخي” آخر، بحسب عبارة سانا مارين، قررت فنلندا الاثنين إرسال أسلحة فتّاكة إلى أوكرانيا بينها 2500 بندقية هجومية و1500 قاذفة صواريخ وذخائر.
ومن المتوقّع أن يُثير انصمام فنلندا و/أو السويد إلى حلف شمال الأطلسي غضب موسكو، في إطار أزمة متفجّرة بين روسيا فلاديمير بوتين والغرب.
وأكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة، أن انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي “ستكون له تداعيات عسكرية وسياسية خطرة”.
وتشير هلسنكي إلى أن هذا التحذير تكرّر في السنوات الأخيرة، رافضةً أن ترى بالأمر تهديداً بالغزو مثلما حصل في أوكرانيا.
وجعلت موسكو من السعي لتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقا سبباً للحرب في قضية تدعي فيها روسيا أنها تعرضت للخيانة منذ سقوط جدار برلين.
وحرصت استوكهولم وهلسنكي في الأسابيع الأخيرة على ترك باب دخولهما إلى حلف شمال الأطلسي مفتوحًا أمامهما مع استبعادهما التقدم بطلب انضمام. وقالت رئيسة الحكومة السويدية ماغدالينا أندرسون مساء الجمعة: “أريد أن أكون واضحة جدًا. إن السويد وحدها، وبطريقة مستقلّة، هي من يختار نهجها في ما يخصّ الأمن”.
——————————————
آثار محتملة للحرب الأوكرانية على الشرق الأوسط
تقرير أميركي يعرض حالة الاستقطاب والتداعيات على النفط والقمح
معاذ العمري
لا يزال العالم يترقب تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ لن تقف آثاره عند القارة الأوروبية فقط، وإنما ستتعدى تبعاته ونتائجه «مناطق النزاع»، كما يجادل البعض بأن منطقة الشرق الأوسط تعد الأقرب لتلك الآثار، على المدى القريب والبعيد كذلك.
وأبرز آثار وتبعات هذه الحرب، هي الآثار الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعتمد كثير من الدول على القمح الروسي، وكذلك على النفط والصناعات الروسية والأوكرانية، بينما ستنشط عمليات «الاستقطاب السياسي» في المنطقة، لتكوين حشد دولي بين الفريقين الغربي والروسي.
وفي تقرير لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدولية بواشنطن، يعتقد جون ألترمان، نائب الرئيس، والمشرف العام على دراسات الشرق الأوسط في المركز، أن آثار الغزو الروسي لأوكرانيا ستنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكشف عن تحالفات «جيوستراتيجية» جديدة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتهدد بإشعال مواجهات عسكرية جديدة، وذلك في حال استمرت المواجهة بين روسيا ومعظم أنحاء العالم لفترة طويلة، كما يبدو مرجحاً، فقد تكون الآثار الأكثر خطورة على المدى الطويل بدلاً من المدى القصير.
ويرى ألترمان الذي ساهم في كتابة التقرير مع ويل تودمان، الزميل الباحث في المركز، أن إيران وسوريا هما أبرز المؤيدين والمصطفين مع روسيا في الشرق الأوسط؛ لأنهم اتخذوا مواقف معادية للغرب ولفترة طويلة. فقد أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا ستعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الإيراني إن الأزمة «متجذرة في استفزازات (الناتو)».
لكن حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الرئيسيين في المنطقة كانوا حذرين، فبينما أدان وزير خارجية إسرائيل روسيا، لم يفعل رئيس وزرائها ذلك على وجه الخصوص.
كما ترى إسرائيل في روسيا شريكاً مهماً. ويشكل المهاجرون الروس جمهوراً مهماً في الناخبين الإسرائيليين.
وترى دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى، أن روسيا حليف مهم في إنتاج الطاقة، ومصدر محتمل للأسلحة والاستثمار والسلع الأخرى؛ حيث عبَّرت تلك الدول عن قلقها؛ لكنها تجنبت إلقاء اللوم على روسيا مباشرة.
ارتفاع أسعار النفط
تسببت الأزمة والحرب الروسية– الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير (شباط) الماضي، في قفز أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد الغزو، وبالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، ستوفر الأسعار المرتفعة تخفيفاً مرحباً بالميزانية على المدى القصير، بعد الضربة الاقتصادية التي خلفتها جائحة «كوفيد– 19».
وعلى عكس ما هو متوقع، على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط المستدام إلى تسريع انتقال الطاقة التقليدية إلى الجديدة، أو المعروفة بـ«النظيفة»، وذلك من خلال جعل مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، في حين أن هناك ضغطاً دائماً بين الدول المصدرة للنفط لتوجيه المكاسب غير المتوقعة إلى رواتب موظفي القطاع العام والإعانات، وقد تستخدم بعض الحكومات جزءاً من الأرباح المكتشفة حديثاً للاستثمار في الجهود المبذولة لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. كما تخشى بعض الدول الإقليمية أيضاً أن تفتقر روسيا إلى الموارد اللازمة للحفاظ على دورها في سوريا، مما يترك فراغاً ستملأه القوات الإيرانية؛ خصوصاً إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وخصصت أسعار النفط المرتفعة مزيداً من الأموال في الخزانة الإيرانية.
نقص إمدادات القمح الروسي والسلع الغذائية
وعرض التقرير جوانب من تأثير الأزمة الأوكرانية– الروسية على خطوط الإمداد والسلع الغذائية العالمية، والتي تسيطر على رُبع الصادرات العالمية؛ حيث قفزت أسعار السلع العالمية إلى أرقام كبيرة تصل في زيادتها إلى 80 في المائة، على الرغم من ارتفاعها أساساً منذ بدء الجائحة، وتفشي وباء «كورونا».
كما ارتفعت العقود الآجلة للقمح في باريس بنسبة 16 في المائة، منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير، بالإضافة إلى ذلك، قطعت روسيا صادراتها من سماد نترات الأمونيوم، وكذلك عديد من البلدان في الشرق الأوسط معرضة بشكل خاص لارتفاع الأسعار وتعطل الإمدادات.
وعلى سبيل المثال، مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي عديد من وارداتها من منطقة البحر الأسود. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية حاولت تنويع إمداداتها في الفترة التي سبقت الغزو، فإن علامات نقص الإمدادات واضحة بالفعل، وربما تظهر خلال الأشهر القادمة. كما أن الحكومة المصرية سارعت في إصدار البيانات والتطمينات بأن لديها مخزوناً كافياً من القمح لمدة تزيد عن 6 أشهر. كما تلقت مصر عدداً كبيراً من العطاءات لمناقصة قمح الأسبوع الماضي؛ لكنها ألغت هذا الأسبوع مناقصة بعد تلقيها عرضاً واحداً باهظ الثمن.
وفي أماكن أخرى من شمال أفريقيا، تتزامن الزيادات في الأسعار وانقطاع الإمدادات مع موجات الجفاف الشديدة. وتأتي التحديات الاقتصادية في وقت صعب للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يبذل جهوداً متجددة لتوطيد سلطته، بعد إقالة البرلمان الصيف الماضي، والذي يواجه ركوداً اقتصادياً متزايداً.
ويجادل التقرير الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، بأن نقص القمح سوف يصيب الدول الهشة في المنطقة بشكل أقوى، فقد قوضت الأزمة الاقتصادية في لبنان بالفعل قدرة سكانه على شراء المواد الغذائية؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1000 في المائة في أقل من 3 سنوات. ويستورد لبنان القمح لتلبية معظم احتياجاته؛ حيث يأتي 60 في المائة منه من أوكرانيا، والبلاد لديها ما يقرب من شهر من القمح في المخزن. كما أن ليبيا واليمن اللتين تمزقهما الحرب معرضتان بشكل مماثل لنقص القمح.
الاستقطاب السياسي والعسكري في المنطقة
توعد الرئيس بوتين البلدان التي تتدخل في العمليات الروسية في أوكرانيا بـ«عواقب لم ترها من قبل»، إذ إن لدى روسيا خيارات عدة لإلحاق الأذى بالغرب في الشرق الأوسط، رداً على العقوبات. وقد تؤدي التوترات إلى قيام روسيا بدور المفسد في سوريا.
بدوره، حذر القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية، اللفتنانت جنرال مايكل كوريلا، من أن روسيا قد انتهكت بشكل متزايد بروتوكولات عدم التضارب مع الولايات المتحدة في شرق سوريا، في الأشهر الأخيرة.
وإذا تدهورت العلاقات بشكل أكبر، وتجنبت روسيا آليات تفادي الصراع، فسوف يرتفع خطر مواجهة أكثر جدية، وستتاح لروسيا فرصة واضحة لتقويض الغرب في يوليو (تموز) المقبل، عندما يصوّت مجلس الأمن الدولي على تجديد عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا.
وربما يعرّض «الفيتو» الروسي 4 ملايين سوري يعتمدون على المساعدة المنقذة للحياة إلى الخطر. ويزيد الضغط بشكل حاد على تركيا، ويمكن أن يؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة القسرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي شددت فيه إدارة بايدن على الدبلوماسية الإنسانية. ومن المرجح أن يؤدي استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) إلى القضاء على أي آمال في التعاون الجاد بشأن الملف السوري، بين الولايات المتحدة وروسيا.
وربما تسعى روسيا إلى زيادة الضغط على أوروبا، من خلال تأجيج الصراع في ليبيا، في وقت هش لعملية السلام. وبالمثل، يمكن لروسيا أن تستغل تهديد الهجرة غير النظامية من ليبيا لزعزعة استقرار أوروبا، مثلما تسارع اللاجئين من أوكرانيا. وأخيراً، يمكن لروسيا أن تعقّد الدبلوماسية الدولية بشأن الملف النووي الإيراني. وفي حين أن غزو أوكرانيا لم يعرقل مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا عن مسارها حتى الآن، إلا أن المفاوضات الناجحة ستظل تتطلب عملية تنفيذ دقيقة، ويمكن لروسيا أن تسعى إلى لعب دور «المعطّل».
الشرق الأوسط
————————–
إحياء مشروع “نوفوروسيا”.. لماذا تخوض روسيا معركة شرسة للسيطرة على مدن الساحل الأوكراني؟
عربي بوست
هل يوشك حلم بوتين القديم بإحياء “روسيا الجديدة” (نوفوروسيا) أن يتحقق..؟ لهذه الأسباب تسعى روسيا للسيطرة بأي ثمن على جميع مدن الساحل الأوكراني/ عربي بوست
يخوض الجيش الروسي معارك شرسة في مدن جنوب أوكرانيا الساحلية على بحر آزوف والبحر الأسود، منذ بدء اجتياح البلاد من عدة محاور، في 24 فبراير/شباط 2022، حيث تسعى موسكو لتوسيع مناطق نفوذ الانفصاليين التابعين لها من دونيتسك ولوغانسك، مروراً بشبه جزيرة القرم -التي ضمتها في عام 2014- حتى مدينة أوديسا جنوب غربي البلاد، ضمن ما يُعرف بمشروع “نوفوروسيا”، أو “روسيا الجديدة”.
“إحياء مشروع نوفوروسيا يقترب”.. الروس يسيطرون على ميليتوبول ومعارك ضارية في خيرسون وأوديسا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، 26 فبراير/شباط، أن القوات الروسية استولت على مدينة ميليتوبول في منطقة زابوريزهيا جنوب شرق أوكرانيا الاستراتيجية، ما يجعلها واحدة من أول المراكز السكانية الكبرى التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء المعارك.
وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن جيشها بسط سيطرته على ميليتوبول، التي استسلمت لها بعد إنزال برمائي بالقرب من منطقة آزوف سكوي المأهولة بالسكان، فيما تتحدث التقارير الغربية عن وجود جيوب للمقاومة في المدينة، وأن دخول القوات الروسية إلى المدينة ترافق مع قتال عنيف في الشوارع.
وبضم الجيش الروسي تلك المدينة الساحلية على بحر آزوف وضواحيها مثل منطقة بيرديانسك، بالإضافة إلى وصوله لمشارف مدينة خيرسون المجاورة، وخوضه معارك ضارية في أوديسا، تقترب موسكو من تحقيق ما تخطط له منذ وقت طويل، وهو إعادة إحياء ما يعرف بمشروع “نوفوروسيا” أو “روسيا الجديدة”.
Russian troops enter Kherson pic.twitter.com/NHV4y9hZYG
— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 1, 2022
تتحدث التقارير الاستخباراتية الغربية منذ وقت مبكر، عن أن أحد أهم أهداف الغزو الروسي لأوكرانيا قد يكون إقامة جسر بري من المناطق الانفصالية في إقليم دونباس، إلى شبه جزيرة القرم، المنطقة التي ضمتها إليها في عام 2014. وسيتطلب ذلك الاستيلاء مئات الكيلومترات من الأراضي على طول بحر آزوف، بالإضافة إلى السيطرة على مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود جنوب غربي البلاد.
وتعرف هذه المنطقة الساحلية الجنوبية تاريخياً باسم “نوفوروسيا، أو “روسيا الجديدة”، وهي جزء تاريخي من الإمبراطورية الروسية على طول البحر الأسود، ويقول تقرير سابق لمجلة Economist البريطانية، إنه سيكون لتلك المنطقة ميزة ملموسة أكثر في التخفيف من نقص المياه في شبه جزيرة القرم، كما أن لموانئها التاريخية أهمية استراتيجية بالنسبة لموسكو التي تسعى لاستعادة حضورها بشكل أوسع على البحر الأسود.
تسعى روسيا للسيطرة بأي ثمن على جميع مدن الساحل جنوب أوكرانيا بهدف إعادة إحياء مشروع “روسيا الجديدة” أو “نوفوروسيا”/ عربي بوست
وتقول المجلة إن مثل هذا “الاستيلاء” على الأراضي سيكون في حدود قدرات القوات الروسية، لكن الأمر الأقل وضوحاً هو ما إذا كانت ستخدم أهداف الكرملين الحربية. فإذا كان هدف روسيا هو منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو أو التعاون مع حلف الناتو، فمن غير المرجح أن يؤدي تعزيز السيطرة على المنطقة الجنوبية، إلى ركوع الحكومة في كييف لبوتين، ولذلك تسعى القوات الروسية في الوقت نفسه لحصار العاصمة والسيطرة عليها، وخلع الحكومة هناك وتقديم أخرى موالية لها، كما كان الحال قبل عام 2014، فيما سيكون السيطرة على مدن الساحل أمراً واقعاً.
إعادة إحياء “نوفوروسيا”.. حلم بوتين الذي يوشك أن يتحقق
منذ شهر إبريل/نيسان عام 2014، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث بوتيرة متزايدة عن مفهوم إعادة إحياء “روسيا الجديدة” أو “نوفوروسيا”، وهي مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا يراها القوميون الروس في روسيا وأوكرانيا مناطق روسية منحها الاتحاد السوفييتي لأوكرانيا.
وقال بوتين في خطابه الذي توجه به إلى الشعب الروسي في إبريل/نيسان 2014، بعد نحو شهر من سيطرة روسيا على منطقة القرم مبرراً ضمها: “سوف أذكّركم: هذه نوفوروسيا (أي روسيا الجديدة)”، مشيراً إلى مناطق شرق وجنوب أوكرانيا، حيث كان بوتين يتخطى المناطق الانفصالية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك والقرم، ليشمل جميع مناطق البحر الأسود الساحلية ذات الأعداد الكبيرة من الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
خطاب بوتين حول أزمة شرق أوكرانيا على شاشات التلفاز في روسيا، 2014/ Getty
استخدم بوتين عبارة “نوفوروسيا” مرة أخرى في بيان رئاسي رسمي في أغسطس/آب مع العام نفسه، توجه به إلى الانفصاليين في شرق أوكرانيا الذين سيطروا على أجزاء من البلاد، حيث وصفهم بـ”قوات نوفوروسيا”، وكان ذلك البيان الذي وصفه موقع VOX الأمريكي حينها بـ”المخيف”، كافٍ لفهم الاتجاه القادم لمشروع بوتين في أوكرانيا.
وقبل بوتين بوقت طويل، كان المفكر والفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، الذي يعرف بأنه “عقل بوتين” والمقرب من الرئيس الروسي، ينادي بشكل كبير في مؤلفاته ومحاضراته بإعادة إحياء مشروع نوفوروسيا التاريخي، قائلاً إن “أراضي نوفوروسيا (روسيا الجديدة) من خاركوف حتى أوديسا، وأخيراً شبه جزيرة القرم، كانت ملكاً للإمبراطورية الروسية، وقد تم احتلالها من قبل الإمبراطورية العثمانية. وأن هذه الأراضي كانت مأهولة بالسكان الأصليين لروسيا العظمى أو من قبل القوزاق “أصدقاء موسكو”، وكلاهما من “روسيا الصغيرة” (أوكرانيا) وتلك التي امتدت إلى جنوب الإمبراطورية الروسية نفسها”.
وبحسب دوغين، “أصبحت نوفوروسيا (روسيا الجديدة) جزءًا لا يتجزأ من الإمبراطورية الروسية. وفي وقت لاحق، تمت استعادة مناطق أخرى من أوكرانيا، هذه المرة مأهولة بشكل أساسي من قبل الأوكرانيين أنفسهم والقوزاق المالوروسيين، وأصبحت هذه الأراضي جزءاً من الإمبراطورية القيصرية الروسية”.
خارطة نوفوروسيا (روسيا الجديدة) في عهد الإمبراطورية الروسية في عام 1897/ wikimedia commons
ويعتبر مصطلح “روسيا الجديدة” أو “روسيا الجنوبية” مصطلحاً تاريخياً للإمبراطورية الروسية، يشير إلى إقليم شمال البحر الأسود، الذي تَشكَّل كمقاطعة إمبراطورية جديدة تابعة لروسيا (مقاطعة نوفوروسيا) في عام 1764، مع أجزاء من المناطق الجنوبية الساحلية، بهدف التحضير للحرب مع الإمبراطورية العثمانية.
وتذكر المصادر التاريخية أن نوفوروسيا توسّعت بصورة إضافية من خلال ضم أقاليم جديدة غرباً في عام 1775، شملت إقليم بيسارابيا التابع لمولدوفا وأقاليم ساحل البحر الأسود في أوكرانيا الحديثة، وساحل بحر آزوف وإقليم القرم وغيرها.
وظلت تلك المنطقة جزءاً من الإمبراطورية الروسية حتى انهيارها في أعقاب الثورة البلشفية في عام 1917، حيث أصبحت بعد ذلك ضمن جمهورية أوكرانيا السوفييتية، وكانت هناك محاولات لإعادة إحياء “نوفوروسيا” منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وكانت أبرز تلك المحاولات محاولة الحركة الانفصالية الموالية لروسيا إقامة دولة نوفوروسيا الاتحادية خلال حرب إقليم دونباس عام 2014.
من دونباس حتى مولدوفا.. روسيا تعمل على عزل أوكرانيا عن بحري أزوف والأسود
يقول المحلل العسكري في صحيفة “إزفيستيا” الروسية، أنطون لافروف، في مقالة له بعيد سيطرة الجيش الروسي على مدينة ميليتوبول الساحلية، يوم 24 فبراير/شباط، إن “الجيش الروسي يعمل على حسم المعركة سريعاً جنوب أوكرانيا”، حيث تعمل موسكو على إحياء مشروع “نوفوروسيا”، كاتحاد كونفدرالي بين “جمهوريتَي” دونباس و5 مناطق ساحلية جنوبية تصل حتى أوديسا غرباً.
ويوضح لافروف أن ذلك يعني أن يعمل الجيش الروسي على السيطرة على المنطقة الممتدّة من ماريوبول حتى أوديسا، وهذا ما يؤدّي مباشرة إلى عزل أوكرانيا عن بحرَي أزوف والأسود، بحيث تتحوّل إلى جيب برّي فقط. مشيراً إلى أن السيناريو المشار إليه سيُمكّن روسيا من الوصول إلى إقليم ترانسنيستريا الانفصالي الموالي لروسيا في جمهورية مولدوفا، وهو ما يُعدّ بالتأكيد مفيداً لموسكو، كونه “سيسمح بإغلاق الملفّ الأوكراني بشكل نهائي”، بحسب لافروف.
خارطة “جمهورية ترانسنيستاريا” الانفصالية عن مولدوفا والمدعومة من روسيا، وخطة ربطها بمشروع “نوفوروسيا”/ عربي بوست
وتعتبر ما يعرف بـ”جمهورية ترانسنيستريا” أو (بريدنيستروفيه)، التي انفصلت عن مولدوفا في عام 1992، وعاصمتها تيراسبول، من مناطق “النزاع المجمد” بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وتقع ترانسنيستريا في الشريط الضيق بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية، ومعترف بها دولياً في الوقت الحالي كجزء من مولدوفا، وهي ذات نفوذ روسي، حيث تقيم بها أغلبية عرقية روسية، كما يحمل معظم سكانها الجنسية الروسية إلى جانب المولدوفية.
وفي عام 2003، أيدت روسيا طلب ترانسنيستريا الحفاظ على وجود عسكري روسي طويل الأمد في المنطقة، وبعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، في مارس/آذار 2014، طلب رئيس برلمان ترانسنيستريا الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وهو ما أثار غضباً من قبل مولدوفا وحلف الناتو.
هدف بوتين تحويل أوكرانيا لـ”دولة حبيسة” دون أهم موانئها
يخوض الجيش الروسي معارك شرسة بحسب مصادر أوكرانية وروسية للاستيلاء على ميناء ماريوبول، وهو أكبر ميناء أوكراني على بحر أزوف، وإذا نجحت القوات الروسية كذلك في تنفيذ “حركة كماشة” من الشرق (دونباس)، والجنوب (القرم) في آنٍ واحد، باستخدام القوة البرية والجوية والبحرية، سينجح الروس في الاستيلاء على الميناء الأهم في أوكرانيا “ميناء أوديسا”.
ويوجد بهذه الموانئ الاستراتيجية العديد من من الشركات الصناعية الكبرى، مثل مصانع الحديد والصلب والأشغال المعدنية، ومصانع بناء السفن والصناعات الكيماوية والفحم، وحتى المواد الغذائية والصناعات النسيجية، كما يوجد فيها أكبر شركات النقل والتجارة البحرية ومطارات ومحطات للسكك الحديدية ومحطات للحافلات للتنقل بين مدن الساحل.
ميناء ماريوبول في جنوب أوكرانيا، 2018، أرشيفية/ kyivpost
ستحرم مثل هذه الخطوة أوكرانيا من الموانئ الاقتصادية الحيوية على طول ساحلها الجنوبي، وتحوّلها إلى دولة حبيسة (أي غير ساحلية)، وتحل المشاكل اللوجستية الروسية القائمة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بتوفير الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم، مثل الماء. وسيتطلب تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة حشد كل القوات التي أدخلتها روسيا من شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الشرقية لأوكرانيا.
وستضطر روسيا أيضاً إلى الانخراط في جهد مُكلّف لاحتلال مدن أوكرانية كبرى، مثل كييف، لتركيع حكومتها وجعل الاستيلاء على الساحل الجنوبي أمراً واقعاً يقر به الأوكرانيون، الأمر الذي قد يُعرّض قواتها لخوض حرب استنزاف صعبة، والدخول بحملة عسكرية مطوّلة، وهو الأمر الذي سيكشفه قادم الأيام.
———————

إيكونوميست: ويلات آلة الحرب الروسية كبيرة وحقيقية، ولكن هل هي مؤقتة؟
إإيكونوميست – ترجمة: ربى خدام الجامع
عندما غزت القوات التي قادها السوفييت تشيكوسلوفاكيا في عام 1968، كانت العملية سهلة، إذ لم يواجه الغزاة من المقاومة سوى القليل، ثم تم نقل رئيس البلاد إلى موسكو في اليوم الثاني للحرب، فتقبل الغرب ما جرى رغماً عنه. حسبما يرى المؤرخ سيرغي راديشكينوف الذي يعلق على ما يجري بقوله: “أما ما نراه اليوم في أوكرانيا فهو لعب بطريقة مختلفة تماماً”.
تتمركز غالبية القوات الروسية الآن على بعد 25 كلم من مركز العاصمة كييف، ومن المرجح أن تقوم بمحاصرتها خلال الأيام المقبلة. كما اخترقت القوات الروسية الخطوط الأوكرانية في الجنوب، وتوجّهت غرباً نحو أوديسا التي تعدّ ميناء مهماً، إلى جانب توجهها شمالاً نحو قلب البلاد، حيث يمكنها محاصرة القوات الأوكرانية في الشرق. في حين تعرضت مدينة خاركيف التي صدّت هجمات عديدة خلال نهاية الأسبوع، لقصف عنيف يوم الاثنين الماضي.
ولكن بالرغم من كل ذلك نجد آلة الحرب الروسية تترنح وتعاني، وذلك لأن الأمور تغيرت عمّا كانت عليه في عام 1968، إلا أن أداءها ظل أسوأ من أدائها في جورجيا في عام 2008 بحسب ما يراه كونراد موزيكا، وهو محلل سياسي مختص بقضايا الدفاع، وذلك لأن تلك الحرب دفعت لقيام إصلاحات كبيرة داخل القوات المسلحة الروسية، لكن تلك الإصلاحات لم تكن شاملة بما فيه الكفاية. إذ تظهر الصور القادمة من أوكرانيا هياكل مشوّهة لمدرعات عسكرية روسية، في حين يظهر مقطع فيديو لما جرى عقب الكمين الذي نصب لرتل عسكري روسي بالقرب من مدينة سومي الواقعة شمال شرقي البلاد يوم الأحد الماضي، خسارة تقدّر بأكثر من عشر عربات مصفحة، بينها دبابتان، ومدفع قاذف، لذا فالسؤال المطروح هنا هو: هل هذه المشكلات مؤقتة أم أنها تشير إلى حالة فساد أعمق بوسع أوكرانيا أن تستغلها؟
تبدو الأمور اللوجستية أكبر مشكلة تعاني منها روسيا، إذ بحسب ما ذكره مسؤول غربي فإن روسيا تعاني من مشكلات محددة تتصل بقطعات الهندسة لديها، فقد فجرت أوكرانيا العديد من الجسور، ولهذا لم تستطع روسيا أن تأتي بقطعات الجسور عبر الطرق المزدحمة. كما تركت دبابات ومركبات روسية أخرى على قارعة الطريق، سواء بسبب تعطلها أو بسبب نفاد الوقود منها، ما يعني أن خطوط الإمداد قد استنفدت طاقتها، كما لم تعد وحدات الدعم قادرة على المتابعة والمواكبة. وهكذا تحولت القطعات التي تقطعت بها السبل إلى أهداف سائغة للكمائن، بما أن القوات الأوكرانية لم تعانِ من أي نقص في الأسلحة اللازمة لاستهداف تلك القطعات، بعدما أصبحت كل من الدنمارك ولوكسمبورغ وفنلندا من أواخر الدول الأوروبية التي أعلنت عن نيتها تزويدَ أوكرانيا بآلاف الصورايخ المضادة للدبابات وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
لم تستطع روسيا تأمين الأجواء أيضاً، إذ يعتقد مسؤولون غربيون بأن الصواريخ الروسية يمكن أن تمسح الدفاعات الجوية الأوكرانية عن بكرة أبيها خلال الساعات الأولى من الحرب، على الرغم من أنها تضم شبكة من الرادارات وصواريخ أرض-جو، فإن الضربات كانت أخفّ مما هو متوقع بكثير، ولعل السبب في ذلك يعود إلى الرغبة في توفير الذخائر التي تتمتع بدقة كبيرة إلى أكبر حد ممكن. ونتيجة لذلك، لم تستخدم روسيا كثيرا من طائراتها الحربية حتى الآن، بالرغم من أن مقطع فيديو انتشر مؤخراً يظهر طائرة سوخوي-34 قاذفة للقنابل وهي تحلق فوق خاركيف وكذلك في جنوبي أوكرانيا.
إن عدم ظهور أي تفوق جوي سيكون له تداعيات كبيرة، أولها عدم توفر دعم جوي ملائم من جهة معينة بالنسبة للجنود، إذ يعدّ ذلك بمنزلة نقطة ضعف تاريخية بالنسبة لروسيا وذلك بسبب ضعف التنسيق بين القوات البرية والجوية بحسب رأي الخبير غاي بلوبسكي المتخصص بالقوة الجوية لروسيا. أما التداعيات الأخرى فتتمثل في أنه صار بوسع أوكرانيا أن تحتفظ بمزيد من الطائرات بما أن روسيا لم تغز الأجواء بطائراتها المقاتلة، وهدف روسيا من ذلك هو الاقتصاد في استخدام الصواريخ، ما يعني أنها تضرب فقط بضع نقاط ضمن المطارات والقواعد الجوية، بدلاً من تدمير تلك القواعد بشكل كامل. كما أن أوكرانيا تستخدم طائرات مسيرة من طراز TB2 تركية الصنع لتنفذ غارات قاتلة على مواقع يُحتمل تمركز القوات الروسية فيها، والتي تبدو وكأنها ليست لديها أدنى فكرة حول ما يجري فوقها. ولهذا يعتقد عدد من الخبراء بأن تلك الطائرات ستستخدم بعد مرور أربعة أيام على الحرب.
تشير كل تلك الأمور إلى عيوب عميقة في التكتيك، ففي الحروب الحديثة، من المفترض أن تتعاون عناصر مختلفة تشمل المشاة والمدرعات والمدفعية والدفاع الجوي وقطعات الهندسة والحرب الإلكترونية، لتسد كل منها عيوب الأخرى ونقائصها، إذ يمكن للدبابة مثلاً أن تمد المشاة بقوة نارية في حال تقدمها، وبالمقابل، يمكن للمشاة الترجل والبدء بمطاردة التشكيلات المضادة للدبابات. إلا أن روسيا تخلط كل تلك الأمور ببعضها، وفي بعض الحالات، تقترب تكتيكاتها من العمليات الانتحارية، إذ يظهر مقطع فيديو تم تصويره في بوتشا وهي مدينة تقع شمال غربي كييف، مركبة مصفحة روسية وهي تقوم بنشر الدعاية الروسية وتوجيه المدنيين بالتزام الهدوء، في حين يتوجه رجل يحمل قنبلة يدوية نحو تلك المركبة ليقوم بتدميرها بكل هدوء هو أيضاً!
لعل أهم سبب يكمن خلف تلك الأخطاء الفادحة يتمثل في عدد الجنود الذين تم نشرهم، إذ خلال الغزو الأخير لأوكرانيا الذي تم ما بين عامي 2014-2015، لم ترسل روسيا أكثر من 12 مجموعة تكتيكية تابعة للكتائب ضمت جميعها ألف جندي، لكنها هذه المرة قامت بإرسال أكثر من مئة مجموعة تكتيكية، فأتت النتيجة على شكل مجموعات تكتيكية مخففة، وصفها أحد ضباط المدرعات الأميركية بقوله: “لم يكن أداء الوحدات الاستخبارية التي تقوم عادة بالتقاط الإشارات التي تصدرها مسيّرات بيرقدار من نوع TB2 وهي تحوم في السماء، وكذلك قوات المدفعية التي تخفف من حدة الدفاعات الأوكرانية كأدائها في عام 2015، وذلك نظراً لعدم توفر ما يكفي من الأعداد لتنتشر ضمن كل مجموعة من مجموعات التكتيك، لذا فإنك الآن تقوم باستبقاء أفضل العناصر لديك حتى تعدّ رغيفاً أكبر بكثير”.
ثمة مؤشرات تدل على ضعف الروح المعنوية لدى بعض تلك القطعات الروسية، إذ يظهر أحد مقاطع الفيديو رتل دبابات وهو يعود القهقرى على عجل بعدما تعرض لمواجهة مع مدنيين عزل. ولهذا يقول ديما آدامسكي وهو خبير بالقوات المسلحة الروسية بأنه دهش من الأعداد الغفيرة من المجندين الصغار، إذ قد يحسّ هؤلاء بالارتباك والتشوّش حيال ما إذا كان خصومهم الأوكرانيون عبارة عن إخوة تربطهم روابط روحية وإنسانية وحضارية، كما سبق لفلاديمير بوتين أن أورد في مقالة نشرت الصيف الماضي، أم أنهم أداة بيد النازيين من مدمني المخدرات، كما وصفهم بوتين مؤخراً وهو يرغي ويُزبد. وفي مدينة بيرديانسك الساحلية التي سقطت بيد الروس يوم الأحد، خرج الأهالي باحتجاجات صريحة في الشوارع ضد قوات الحرس الوطني الروسية.
ولهذا خلص بعض المسؤولين الغربيين والخبراء العسكريين إلى أن الجيش الروسي ما هو إلا نمر من ورق، حيث يقول ب.أ. فريدمان وهو محلل عسكري وضابط احتياط في فيلق سلاح مشاة البحرية الأميركي: “إن هذا ليس بجيش جيد ينفذ خطة سيئة… أو تكتيكات خارج السياق، بل إنه جيش رديء!” في حين أبدى محللون آخرون حذرهم وتحفظهم، إلا أنهم ذكروا بأنه يمكن للتكتيكات الروسية أن تتكيف وتصبح أفضل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما أن الشعب يلتفّ حول القيادة ويؤيّدها، ولكن ينبغي على روسيا أن تنشر ربع قواتها على حدودها مع أوكرانيا، بحسب ما يراه مسؤولون أميركيون، إذ هنالك رتل عسكري روسي تم نشره على مسافة تبعد عن العاصمة كييف مسافة 27 كلم جنوباً، ويمتد لـ27 كلم أخرى على الطريق بحسب ما التقطته صور الأقمار الصناعية. ويعتقد المسؤولون الأميركيون بأن الكرملين أرسل إلى أوكرانيا مقاتلين من مجموعة فاغنر، وهي عبارة عن جماعة مرتزقة مرتبطة بالكرملين.
حتى الآن، بذلت روسيا كل ما في وسعها لتجنب وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين مقارنة بما فعلته في حملتها الجوية التي شنتها في سوريا، وبصورة فاقت التوقعات عند بداية النزاع، وذلك بحسب رأي المحلل آدامسكي، إلا أنه حذر من أن الحرب قد تدخل “مرحلة أبشع”، وهذا ما نراه جلياً في خاركيف، بعدما أخذت الصواريخ والذخائر العنقودية تستهدف المناطق السكنية، فتسببت بأضرار واسعة لحقت بمبان بكاملها، كما تظهر الصور الجثث وقد انتشرت في الشوارع، إذ يشير ظهور طائرات سوخوي-34 القاذفة للقنابل إلى أن هذه المدينة ستتعرض لقصف جوي قريباً، بما أن رهان بوتين على حرب سريعة قد باء بالفشل، ولهذا نجده اليوم وقد أعد العدة لخوض حرب أكثر قتامة وأشد تجهماً.
المصدر: إيكونوميست
—————————–
كيف أشعل الناتو فتيل الحرب العالمية الثالثة/ حسن إسميك
انتهت الحرب الباردة الثانية وبدأت الحرب العالمية الثالثة. وحين تُطلق الرصاصة الأخيرة وينحسر الدخان، سيحكم التاريخ على الناتو، إن لم يكن السبب الرئيسي للحرب، فبالتأكيد أحد أهم ثلاثة أسباب. وحينها… لا يلومنّ الناتو إلا نفسه.
في مثل هذا الشهر قبل 15 عاماً، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر الأمن الدولي أن وضع الناتو “قواته في الخطوط الأمامية على حدودنا… يمثل استفزازاً خطيراً يقلل من مستوى الثقة المتبادلة، ولدينا الحق في أن نسأل: ضد من هذا التوسع؟”.
لماذا أشير لهذا الخطاب الآن؟ لأني أرى فيه اللحظة التاريخية حين أعلن بوتين رفض بلاده المطلق لحلف الناتو، وسعيه الشخصي لاستعادة العمق الاستراتيجي وهيمنة الاتحاد السوفياتي السابق. لقد كان ذلك الخطاب وعن حق، إيذاناً رسمياً ببدء سباق التوسع بين الناتو وروسيا.
بوتين لم يرغب أبداً أن يكون جزءاً من النظام الدولي الحالي، بل أراد نسفه. والناتو أشعل له الفتيل.
بعد تشكيله في عام 1949 لتمكين أعضائه الـ 12 الأصليين من الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم يشنه أي طرف خارجي – روسيا وألمانيا الشرقية على وجه الخصوص – قبل الحلف اليونان وتركيا في 1952، وألمانيا الغربية في 1955 وإسبانيا في 1982، وعلى الرغم من المعارضة الروسية الضخمة، قبل الحلف مرة أخرى في العام 1999 ثلاث دول سابقة من حلف وارسو؛ بولندا والمجر وجمهورية التشيك، ثم في عام 2004 فتح أبوابه أمام سبع دول جديدة من أوروبا الوسطى والشرقية: بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وبعد خمسة أعوام، انضمت له ألبانيا وكرواتيا، ثم الجبل الأسود، وأخيراً مقدونيا.
وعلاوة على ذلك، قامت الولايات المتحدة ببناء قاعدة جوية في قيرغيزستان، التي ترتبط بعلاقات تاريخية واقتصادية مع روسيا، بحجة أنها قاعدة مؤقتة إثر أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، استخدمتها لشن غزوها على العراق. وفي عامي 2004 و2005، أدت الثورات في جورجيا وأوكرانيا وقيرغيزستان إلى وصول حكومات موالية للغرب إلى السلطة، وفي دول يعتبرها بوتين خاضعة للحكم السوفياتي، الأمر الذي زاد من تأجيج غضبه الملتهب.
وعندما بدأ الناتو في مغازلة أوكرانيا، كان ذلك بمثابة إشعال عود الثقاب لتبدأ على إثره حرب باردة جديدة، ومن منظور طويل للتاريخ، انفجرت الحرب العالمية الثالثة بعد ثوانٍ في حركة بطيئة.
عارض بوتين التقارب الغربي مع أوكرانيا على كافة الصُعد؛ عسكرياً من ناحية انضمامها للناتو، وسياسياً واقتصادياً من ناحية تطوير كييف روابطها مع الاتحاد الأوروبي. لقد كانت أوكرانيا “الديموقراطية” التي تتلقى دعماً رسمياً من الأطلسي في تلك المستويات الثلاثة بمثابة تهديد لروسيا، وهذا سبب كاف سيدفع بوتين عام 2008 ليرسم خطاً أحمر عميقاً في الرمال إثر الوعود التي قدمها قادة الناتو لأوكرانيا بأنها يمكن أن تنضم يوماً ما للحلف.
أما اختيار بوتين لهذا التوقيت بالذات ليعلن غزو كييف، فنابع في الغالب من كونه يستشعر حالة الوهن التي يعيشها حلف الناتو اليوم، في ظل قرار إدارة بايدن تركيز مواردها السياسية والاقتصادية والعسكرية على آسيا، وليس على أوروبا أو الشرق الأوسط. كان هذا التوقيت مثالياً لبوتين أيضاً لأنه كان يعلم أن الرئيس الأميركي لا يحظى بالدعم الكامل، حتى من حزبه، في الدفاع عن أوكرانيا.
فقد حذرت النائبة براميلا جايابال، رئيسة الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي، بايدن في كانون الثاني (يناير)، حين صرحت بالقول: “لدينا مخاوف كبيرة من أن عمليات نشر القوات الجديدة، والعقوبات الشاملة والعشوائية، وتدفق مئات الملايين من الدولارات من الأسلحة الفتاكة، ستزيد من التوترات وتزيد من فرصة سوء التقدير”.
ولكن يبقى الأمر الأهم في كل ذلك هو إدراك بوتين لأهمية أوكرانيا ذاتها، أضف لذلك أن الفائدة من توسع الناتو لم تكن أمراً متفقاً عليه داخل المنظمة ذاتها، والتي يعتمد أعضاؤها الأوروبيون بشكل شبه كلي على النفط والغاز والفحم الصلب الروسي، وبالتالي كانوا مترددين في إثارة غضب روسيا دون داعٍ.
ومن ثم، وبدلاً من “أم كل العقوبات” التي كانت ستدمر الاقتصاد الروسي بعد عزله عن النظام الاقتصادي الدولي، استقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على عقوبات ضعيفة – استهدفت بنكين روسيين فقط، وثلاثة من أصدقاء بوتين المقربين على قائمة العقوبات الأميركية وتجميد عمليات الشراء المستقبلية للديون السيادية الروسية بدلاً من جميع مشترياتها. ومن المتوقع ألا يكون لهذه العقوبات الضعيفة أي تأثير بالنظر إلى التحالف الروسي الصيني الموقع في بكين عشية الأزمة الأوكرانية.
وكما قال الشاعر العربي الكبير المتنبي:
“فَصِرْتُ إذا أصابَتْني سِهامٌ تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ”!
لقد دخل التحالف الروسي الصيني حيز التنفيذ بالفعل. ورداً على الأسئلة بشأن حلف الناتو خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، أجاب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشكل واضح، “هل التوسع المستمر للناتو نحو الشرق سيفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أوروبا؟ هذا سؤال يحتاج الأصدقاء الأوروبيون إلى التفكير فيه بجدية”، لقد كان جوهر السؤال الذي وجهته الصين للناتو: هل حقاً تستحق أوكرانيا أن تندلع حرب عالمية ثالثة؟
كان الناتو على علم بما هو على المحك حقاً في موضوع أوكرانيا. ليرد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ على سؤال يي واصفاً الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه “أخطر لحظة في الأمن الأوروبي على مدى جيل كامل”.
ستسفر نتيجة الحرب على أوكرانيا عن انبثاق نظام عالمي صيني روسي جديد يُنهي هيمنة أميركا أحادية القطب، وستثبت قدرة روسيا على توسيع حدودها إلى ما هو أبعد من أوكرانيا. يتمثل الهدف النهائي لبوتين في إعادة تشكيل كامل الهيكل الأمني لأوروبا، ليضمن بذلك توسيع وتوطيد هيمنة روسيا وعمقها الاستراتيجي.
لا يلوم حلف الناتو إلا نفسه. فقد أطلق كلاب الجحيم حين فتح أبوابه للتوسع الشرقي. وقريباً من هذا أشار روبرت كاغان، مؤلف مقالة استشرافية نشرتها “فورين بوليسي” بعنوان “الدعم في الحرب العالمية الثالثة”، وكتب مؤخراً في مقال آخر: “مع تقاسم بولندا وهنغاريا وخمسة أعضاء آخرين في الناتو حدوداً مع روسيا الجديدة الموسعة، فإن قدرة الولايات المتحدة والحلف على الدفاع عن الجناح الشرقي للتحالف سوف تتضاءل إلى حد كبير”.
الانقسام العالمي اليوم ليس أيديولوجياً فحسب، بل سياسي واقتصادي وتكنولوجي وسيبراني، ما يعني أن نطاقه أوسع امتداداً ومواجهاته أعلى تكلفة والتنبؤ به أكثر صعوبة، وبالتالي ستكون صراعاته أكثر كارثية.
وإذا تمكن حلف الناتو من الخروج من الأزمة الأوكرانية الحالية بأقل الخسائر الممكنة، وهذه مهمة ليست باليسيرة أبداً، فهذا يحتم عليه إجراء تقييم شامل وعلى الفور، لمكانته ودوره وموقعه في العالم، وتقييم فعالية تحالفاته، ومن ثم إعادة بناء استراتيجياته على هذا الأساس، خاصة وأن التحالف الصيني الروسي الذي تم تشكيله حديثاً، مستعد ومتربص وجاهز لانتهاز أي نقاط ضعف دون أي تردد.
النهار العربي
——————————-
في ارتدادات الحرب في أوكرانيا على سوريا/ شورش درويش
ليس ثمة أهمية لموقف النظام السوري بالاصطفاف خلف موسكو في هجومها على أوكرانيا، ولا يهتم العالم إلى ذلك أن يقول رأس “النظام السوري” أن غاية روسيا من الحرب “تصحيح أخطاء التاريخ” أو أن روسيا “تدافع اليوم عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية”، ذلك أن النظام سواء أعلن اصطفافه المتوقّع أم آثر الصمت فإنه في كل الأحوال شريك روسيا في سوريا، في المغنم والمغرم، وأن ما يحصل في أوكرانيا سيكون له صدى بعد أن تتلاشى رائحة البارود، والبداهة تقول إن تحقيق روسيا غاياتها سيقوّي من حضورها في سوريا وسيدعمّ النظام، والعكس بالعكس، بكلمات أقل: آلت سوريا قاطرة مرتبطة بإحكام شديد إلى القطار الروسيّ.
قد لا تظهر الارتدادات على الساحة السوريّة باكراً، سوى تلك المرتبطة بضبط النفقات العسكرية في سوريا، وهو ضبط مقترن باستدامة الحرب في أوكرانيا، ذلك أن روسيا ليس بوسعها التوسّع في الإنفاق العسكري على ما تقوله الأرقام وحالة الاقتصاد الروسي غير المستقر والذي تحيطه عقوبات اقتصادية عاجلة والتي قد تبلغ أوجها مع عزلها عن نظام سويفت SWIFT، فضلاً عن أن روسيا لم تتعهّد بتحسين أحوال السوريين. ولم تنفق، خارج الإنفاق العسكري، ما يستحق الوقوف عليه لتحسين أحوال السوريين أو تقديم الخدمات الأساسية لهم، إلّا إذا اعتبرنا صناديق المساعدات الإنسانية والدعائية بأنها غاية الأمر بالنسبة للسوريين.
تحذّر الأمم المتحدة من أن 14.6 مليون شخص باتوا بحاجة إلى المساعدة في سوريا، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشي باحتمالات تعرّض مناطق سيطرة النظام لمزيد من الاضطرابات وتنامي حركة الاحتجاجات في بعض المناطق، لا سيّما مع إرجاء النظام الاتفاق مع الإدارة الذاتية والاستفادة من الموارد المهمّة التي تديرها الإدارة خاصة قطاع النفط. يأتي ذلك في ظل المخاوف من أزمة غذاء قد تضرب بأطنابها العالم وخاصة الدول الفقيرة كسوريا التي تعتمد على روسيا في إمدادها بسلال القمح، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا يساهمان في إمداد العالم بـ 29% من احتياجاته من القمح، فيما تدرس دمشق في هذه الأثناء عرضاً مقدماً من إقليم القرم لتزويدها بالقمح للعام الجاري، إلى ذلك قفزت أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية بمقدار 6% للبرميل الواحد.
تضاعف”المقاومة” في أوكرانيا خلال الحرب الدائرة من احتمالات تثبيط الهجوم الروسي وتكبيده الخسائر والحط من هيبة الجيش الروسي وأسلحته التي اختبرها في سوريا خلال السنوات الماضية (رغم الاحتمالات المتصلة بتحطيم أوكرانيا وتدميرها أو تقسيمها)، ما يعني أن نجاح المقاومة سيفضي إلى تهافت استراتيجية بوتين القاضية بالسيطرة على أوكرانيا وتنصيب حكومة موالية لموسكو، ولا شك أن تحقق ذلك من شأنه تقويض استراتيجية بوتين في سوريا أيضاً حيث تتنامى احتمالات استلهام التجربة الأوكرانية والتفكير في مقارعة الجيش الروسي وعدم الاكتراث للقوة الروسية طالما أنّها قابلة لأن تهزم، وتحقّق ذلك مقترن دائماً بما سيحصل في أوكرانيا، ولا يعني ذلك أن الهزيمة أو الانتصار حتميان هناك بقدر ما تنصبّ محاولة التحليل هنا على فكرة “تورّط” روسيا في حرب تضعفها وتتسبّب في عزلها دولياً وبالتالي تخرجها من حلبة التنافس مع الدول الكبرى، الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
وجه آخر للصدى الأوكراني جاء على لسان فيصل المقداد، وزير الخارجية السورية، الذي حاول خلال مشاركته في أعمال نادي فالداي بروسيا، إرجاء مواجهاته إلى مرحلة لاحقة، إذ تودّد للإدارة الذاتية ولقوات سوريا الديمقراطية دون أن يقطع وعوداً بالاتفاق معها، وإن كانت كلماته تستبطن تهديداً واضحاً، لكنه إلى ذلك بدا ودوداً مع الأتراك من منصّته الروسية، فلم يستبعد “تطبيع” العلاقات مع تركيا، وإن بشروط مكرّرة، ويعني ذلك أن النظام بات أسير الحرب في أوكرانيا، ويحاول شراء الوقت ما أمكن، بدل أن يمضي في فرص السلام المتاحة حالياً والتي قد تتلاشى مجدّداً مع تبدّل الأحداث في أوكرانيا لغير صالح روسيا.
في الغالب لم تكن موسكو تتوقّع أن يتشكّل حلف عريض اتخذ من إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا عنواناً له، ذلك أن المتوقّع كان انقساماً أوروبياً وتسليماً غربياً بقَدر كييف الروسي، فهل ستتوقّف مطاردة موسكو في أوكرانيا فقط أم أنها ستطاول الوجود الروسي على المتوسّط، وسوريا، أيضاً؟.
من المستبعد أن يعني التضييق على روسيا دعم جماعات المعارضة المسلّحة أو الجماعات الإسلامية الراديكالية في سوريا، إذ أنه ثمة افتراق عظيم بين هذه الجماعات وبين ما يصطلح على تسميته المقاومة الأوكرانية، وهو ما يعني أن لسوريا خصوصية تمتاز من خلالها عن أوكرانيا، وهو ما قد يريح النظام إلى حين.
ومن الصعب أن تشذّ أو تخرج تركيا عن قواعد اللعبة مع روسيا في سوريا والتي تبدو شبه راسخة، هذا أيضاً يخفّض من حماسة المعارضة التي تستبشر خيراً في ما يجري بأوكرانيا من احتمالات تعثّر روسيا أو هزيمتها على المدى الطويل، فضلاً عن صعوبة إقناع الغرب بتبنّي المعارضة السورية البائسة أو إعادة تدويرها، وعليه فإن المؤشرات قد تقودنا إلى احتمال آخر مفاده الإبقاء على الأوضاع في سوريا على ما هي عليه مع نجاح روسيا أو فشلها في مسعاها العسكري في أوكرانيا.
نورث برس
———————————-
في انتظار برسترويكا جديدة/ بلال خبيز
أسفرت حرب الرئيس الروسي على أوكرانيا عن نتيجة مبكرة. أوروبا تتسلح والولايات المتحدة تستعيد نفسها الإمبريالي المتجاوز لحدودها الجغرافية والاقتصادية. ومعنى أن تتسلح أوروبا لا ينحصر طبعًا بالحروب التي تعتزم خوضها أو الحدود التي تريد الدفاع عنها. التسلح يعني في المحصلة انتباهًا شديدًا لما يجري خارج الحدود الأوروبية التي استمرت طوال العقود المتأخرة مقفلة في وجه الكوكب. وعلى النحو نفسه، فإن الولايات المتحدة تحث خطاها لتترك سياسة التخلي والانصراف عن شؤون العالم نحو تدخل فاعل فيه مرة أخرى. هذا يذكر قليلًا وكثيرًا بالحقبة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي والتدخل الأمريكي أساسًا والأوروبي والروسي عرضًا في يوغوسلافيا السابقة.
هذا من جهة كثرة أوجه الشبه، أما ما يحيل إلى قلتها فهو المسعى الأوروبي الواضح لتدبر أمن القارة بأيدي دولها الكبرى. وهذا في حد ذاته سيترك أثره الأكيد على العلاقات الأوروبية – الأمريكية من جهة، وسيعيد لأوروبا سيفها الإمبريالي الذي ندر خلال العقود الماضية أن استلته من غمده. والحق إن هذا التطور لا يقع حكمًا في صالح الرئيس الروسي وسياساته المستفزة. فهذه دول تملك إن قررت الحرب القدرة على تمويل مسير جيوشها وتأمين خطوط إمدادها، والحؤول دون نفاد الوقود في الدبابات المهاجمة قبل أن تصل إلى وجهتها، على ما يحصل تكرارًا مع الجيش الروسي المجتاح. وهذه دول تستطيع أيضًا أن تمول حروبها على نحو يسمح لها بالاستمرار في المعارك لوقت طويل، وليست حالها حال روسيا التي إن طالت حربها في أوكرانيا ستجد نفسها عاجزة عن سحب جنودها لأنها لا تملك ما يكفي ليقيم أود الانسحاب.
مع ذلك، ورغم كل الوهن الإمبراطوري الروسي، إلا أن القيادة الروسية، التي يحتكر بوتين قراراتها، قادرة على إحداث اضطراب شمشوني في العالم. إذ لم يمض أسبوع على الحملة الروسية على أوكرانيا حتى بدأ بوتين يلمّح إلى استخدام النووي. كما لو أن الوقود قد نفد من كل أسلحته الأخرى. وبالنظر إلى التاريخ السياسي الروسي القريب، فليس ثمة ما يمنع، نظريًا، من وضع هذا الخيار على الطاولة. فهذا بلد يملك من الموارد ما يفيض عن حاجة الكوكب كله، لكنه مع ذلك يعاني من أزمة معيشية مزمنة، وأزمة اقتصادية تجعل اقتصاده يدور في حلقة مفرغة، ويكاد الاقتصاد الروسي برمته يشبه طبقة عاملة عالمية تؤمن المواد الأولية لدول أخرى من دون أن ينجح، في تحقيق وفرة تؤهله لتطوير موارده وتحقيق الثروة.
نحن في الحقيقة أمام فيل يائس ومسجون داخل حدوده، وهو كلما تحرك كلما أحدث تدميرًا إضافيًا في مداره الداخلي. والأرجح أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشاهد حجم الدمار الذي تلحقه سياساته والردود عليها في بلاده، سيحاول إخراج الفيل إلى خارج الحدود عله، حين يتحرك يترك دمارًا في الخارج من شأنه أن يقرّب أحوال أوروبا من أحوال روسيا نفسها. فتصبحان معا مرتعا للخراب.
الخلاصة المفزعة من هذه المغامرة اليائسة تفيد بما يلي: لا تعمل سياسات الولايات المتحدة وأوروبا لصالح الكوكب وأهله. هذا صحيح، لكن هذه السياسات حاذرت وتحاذر من جعل العالم غير قابل للحياة. في حين أن المسار الروسي واضح منذ البداية: مشروع إمبراطوري لا يملك مقوماته الحيوية. وحين يجنح إلى اجتياح ما يقع خارج حدوده يجعل الكوكب أفقر والحياة أقصر والعالم أقرب إلى نهايته المفجعة.
والحق إن ردع مثل هذا المشروع لن يكون ممكنًا بإعلان الحرب عليه، وحده الشعب الروسي هو من يجدر به أن يكبح جماح هذا الجنون، وهذا أمر ممكن في روسيا، لأنه تكرر مرتين على الأقل في التاريخ الحديث: مرة حين انسحب جيش ليون تروتسكي أمام الجيش البروسي من دون قتال، بدعوى أن الثورة البلشفية لا تريد الحرب مع أحد، ومرة حين قرّر غورباتشيف أن التوسع الإمبراطوري السوفييتي لا يؤدي إلا إلى إفقار البلاد التي توسع فيها. وتاليًا فمن الأفضل التخلي عن الأحلام الإمبراطورية فلربما تنجح هذه الدول التي كانت تدور في فلكه المعتم في الخروج نحو الضوء.
الترا صوت
————————-
لا ترتبط بشخص بوتين… العقيدة العسكرية الروسية في مواجهة الغرب/ محمد سعد
“إن فن الحرب الأسمى هو إخضاع عدوك دون قتال” (صن تزو، “فن الحرب”).
كانت لحظة تفكك الاتحاد السوفياتي هي اللحظة الفاصلة في نمو الروح القومية المضادة للغرب عند رجال الظل المتخفّين في دهاليز الأجهزة الأمنية والاستراتيجية للدولة الروسية العتيدة.
تسبب هذا السقوط بجرح في “الكبرياء القومية” لهؤلاء، جرح رسّخته تصرفات غربية لم تراعِ نمو تلك الروح القومية، بل استغلت الضعف الروسي في تحقيق مزيد من المكاسب على حساب الدب الجريح.
شعر هؤلاء بأن روسيا يتم إذلالها ويجب أن تقف مرة أخرى لتنتقم ممَّن أذلّوها. وطوّرت تلك النخبة استراتيجية إعادة الهيبة لروسيا بتبني أفكار مستقاة من نظرية الواقعية الهجومية التي طورها الأكاديمي الأمريكي جون ميرشايمر.
تطور الاستراتيجية الروسية
يرى ميرشايمر أن الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي مسؤولة عن تعزيز سلوك الدولة العدواني في السياسة الدولية. ولضمان الوجود في هذه البيئة الدولية الفوضوية، ينبغي على الدولة تطوير قوة هجومية قادرة على فرض سياساتها بالقوة، فالأمن لن يتوفر إلا بمزيد من العدوانية في البيئة الدولية ضد أي إضرار بالمصالح.
رسمت واقعية ميرشايمر العدائية ملامح التفكير الاستراتيجي لرجال الظل، أبناء مدرسة المخابرات السوفياتية KGB. وتعاظمت العدائية في الاستراتيجية الأمنية الروسية تحت إحساس النخب الأمنية بأن بلادهم تم إذلالها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتوسُّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا ونشره في مجال روسيا الحيوي صواريخ هجومية لم يكن يجرؤ على نشرها إبان الحقبة السوفياتية.
وسواء كان هذا الإحساس حقيقة أم مبالغة إلا أنه رسم خطوط الاشتباك في العقل الاستراتيجي الروسي لسنوات، حتى قبل وصول الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين إلى الحكم.
تبنى العقل الاستراتيجي الروسي هذه الرؤية نظرياً بداية من عام 1992 وهو العام الذي نُشر فيه ما يُعرف بمسودة العقيدة العسكرية الروسية. كانت تلك العقيدة محمّلة بأفكار أمنية تصادمية، تختلف عن اللهجة الدفاعية للعقيدة السوفياتية في ثمانينيات القرن الماضي.
بوصول بوتين إلى الحكم، وجد نفسه أمام أكبر تحدٍّ أمني. كانت سبب الأزمة الأمنية برأيه هو الفجوة بين النظرية والتطبيق، نظراً إلى الفرق الشاسع بين الإمكانيات الروسية في الأسلحة التقليدية وإمكانيات الغرب. فبين عامي 1992 و2008، كان النظام الروسي يتبنى نظرياً استراتيجية أمنية هجومية، إلا أنه كان غير قادر على تطبيقها عملياً بسبب اعتبارات مثل الحروب الداخلية في الاتحاد الروسي ذاته، والضعف الاقتصادي وعدم القدرة على مجاراة التفوق الغربي الذي ظهر في جيل جديد من الحروب، مثل حرب الخليج 1991، يعجز الروس عن مجاراتها.
وكان جيل الحروب الجديد هذا يحمل تكنولوجيا جديدة على العسكر الروسي، مثل الصواريخ الموجهة الدقيقة، ونوع جديد من القيادة والسيطرة المتقدمة تجعل القرار أكتر سرعة وفقاً لمعطيات العمليات العسكرية، ونوع جديد من الاستطلاع والتخابر يعتمد على الحروب السيبرانية والبيانات الإلكترونية.
استراتيجية صيد الغزال المتمرد
كانت سنة 2008 نقطة فاصلة في تطوير الاستراتيجية الروسية عملياً على أرض العمليات العسكرية. بدأت العسكرية الروسية في تبني بعض التكتيكات الغربية في حربها في جورجيا لمنع الأخيرة من الانضمام إلى الناتو.
بعد نجاح الحملة الروسية على جورجيا، خرج الاستراتيجيون الروس بأكثر الدروس خطورة على استقرار النظام الأمني في أوروبا. كان الدرس الأهم من تلك الحرب هو أن القوة العسكرية هي وحدها القادرة على منع الدول الصغيرة المحيطة بروسيا من الانضمام إلى الناتو، بعد عدم إصغاء الغرب لكل المطالبات الدبلوماسية بعدم التوسع.
يمكن أن نسمي هذه الاستراتيجية باستراتيجية اصطياد الغزال المتمرد، وتعتمد على تركيز الهجوم على دولة صغيرة في التخوم الروسية تريد أن تلتحق بركب الناتو، على أن تتم عملية الهجوم قبل التحاق تلك الدولة الفعلي بالحلف الأطلسي، بحيث لا تدخل روسيا في مواجهة أكبر مع دولة عضو في الناتو، مع ما يعنيه ذلك من مواجهة مدمرة بين قوى نووية.
تحوّل الأمر إلى سباق بين روسيا والناتو. نجح الأخير في إنجاز مهمة ضم دول البلطيق في مرحلة ضعف روسيا، لكن في مرحلة التمدد الروسي فشل في ضم جورجيا وأوكرانيا.
هل المشكلة في بوتين؟
الإجابة البسيطة المباشرة، لا. المشكلة تكمن في الروح القومية المسيطرة على قطاع عريض من الروس ومنهم المفكرون الاستراتيجيون الذين رسموا استراتيجية الانتقام منذ أوائل التسعينات.
تشكّلت هذه الاستراتيجية عبر عقود سبقت قبل وصول بوتين إلى الحكم، على خلاف ما يتصوره البعض من أنها أفكار فردية في عقل سيد الكرملين.
كان بوتين بالنسبة إلى العقل الأمني للدولة الروسية ضرورة اللحظة التاريخية. صعد من القلب الصلب للاستراتيجية الروسية. هو يعرف تماماً الأساطير المؤسسة لتلك الاستراتيجية ومتأثر تماماً بها وجاء بهدف أن ينفذ خطة إعادة الهيبة الروسية المفقودة.
وبعد نجاحات على المستوى الاقتصادي وتحسن أحوال الطبقة الوسطى الروسية التي انتعشت بعد انهيارات كبيرة في عهد الرئيس بوريس يلتسين صاحب نظرية العلاج بالصدمة، اكتسب بوتين شعبية سمحت له بأن يتصرف كقيصر، خاصة بعد النجاحات التي حققها، بأقل مجهود، في حرب الشيشان الثانية، حيث اتّبع استراتيجية تفكيك المقاومة من داخلها وتحويل الصراع إلى صراع شيشاني-شيشاني، بعد الخلاف الكبير بين السلفيين والصوفيين، ما جعله يجد ضالته في رمضان قديروف، المقاوم السابق والحليف الحالي.
بدأ بوتين في خطوته التالية لإعادة إحياء الإمبراطورية بالتمدد في المساحات التي تركها الغرب في الشرق الأوسط. حاول تقديم نفسه كقوة يمكن الاعتماد عليها في صراعات دولية وأهلية، فتمدد في شمال إفريقيا وإقليم الساحل والصحراء، وكان تدخله الأبرز في سوريا، واعتمد على الحروب الهجينة التي تختلط فيها شركاته الأمنية مع أجهزة مخابراته مع الأجهزة العسكرية والأمنية ويتلاشى فيها الفارق بين ما هو رسمي تابع للدولة وغير رسمي تابع للشركات الخاصة التي تنفّذ استراتيجية الدولة دون أن تتحمل الأعباء السياسية التي تقع على الحكومات، مما خلق مساحة تعيد تقديم روسيا كقوة عظمى من جديد.
الخلاصة
طورت روسيا واقعية هجومية صُنعت أول ما صُنعت في مراكز البحث والجامعات الأمريكية على يد أكاديميين أمريكيين مثل ميرشايمر، لكنها طورتها على طريقتها وأكدت حضورها في ثلاث مناسبات كبرى في فترة زمنية وجيزة نسبياً: الأولى هي الحرب في جورجيا عام 2008 والتي نتج عنها الاعتراف باستقلال إقليميْ أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وإفشال الخطط الجورجية من الانضمام إلى الناتو.
المناسبة الثانية كانت عملية ضم القرم، وهي كانت أراضي عثمانية احتلتها روسيا وضمتها سنة 1783 بعد الحرب مع الدولة العثمانية، ثم ألحقت بأوكرانيا بقرار إداري سوفياتي سنة 1954، قبل أن تعيد روسيا احتلالها في 2014.
والآن، يبدو أننا أمام العملية الثالثة التي تهدف إلى تقسيم أوكرانيا بشكل أكبر وشل قدراتها على الالتحاق بالناتو.
تبدو هذه العمليات لأي متابع على أنها سلسلة من الأفعال العدوانية التي تتزايد مع الوقت خاصة أن بوتين يتحرك في مساحات جديدة للسيطرة لكي يحقق حلمه الشخصي كقيصر روسيا الحديثة. لكن بغض النظر عن التوصيف الأخلاقي، فإن محاولة فهم الأسباب والدوافع لهذه العمليات تقودنا للوصول إلى دافع رئيسي وراءها جميعاً يظهر في كل مرة، وهو دافع الرد على الإذلال المتخيل في عقل النخب الروسية ومنع تمدد الخصم التاريخي وهو حلف الناتو الذي قام كحلف لمواجهة روسيا السوفياتية في الأساس.
حاول الناتو اختبار جدية روسيا في أكثر من مناسبة بعد ضم دول البلطيق سنة 2004 وحاولت روسيا أن ترسل رسالة مفادها أنها لن تسمح بتكرار أخطائها الكبرى. تكرر الحدث وتكرر الرد. وكأنّ روسيا ترفع كل فترة لافتة كبيرة بلون أحمر قانٍ موجهة للناتو تقول فيها بلغة واضحة ومباشرة: “ممنوع الاقتراب”. وفي كل مرة، يتجاهل الناتو هذه اللافتة.
يبدو الناتو كما لو كان مصمماً على اختبار جدية روسيا في كل مرة، فيذهب في نفس المسار وتحدث نفس المواجهة على ساحة جديدة لا يتضرر منها الناتو مباشرة.
وفي كل مرة، تحاول روسيا أن تثبت جديتها ويحاول الناتو بدوره اختبار جديتها، تقع ضحية جديدة لصراع العمالقة. يدفع الضحايا ثمن الفزع التاريخي المتبادل بين روسيا والغرب. ويتشارك الضحايا في أنهم بلاد صغيرة نسبياً تحكمها نخب لا تستوعب جيداً دروس ديكتاتورية الجغرافيا.
فروسيا تشعر دائماً بانكشافها الجغرافي لأي غزو، ما يجعلها شديدة الحساسية لاستحضار الناتو على حدودها أو في مجالها الحيوي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق… كما يشعر الناتو بنفس الفزع التاريخي من روسيا التي تشكل له أقرب منطقة تهديد على حدوده تمثل قيماً مختلفة عن قيمه واستراتيجية متعارضة مع استراتيجيته.
العملية الروسية في أوكرانيا هي تجلٍّ جديد للصراع القديم والروح العدائية التي تحكم علاقة روسيا بحلف الأطلسي، تظهر فيه أوكرانيا كساحة معركة وليست كهدف.
ظهرت الروح العدائية الروسية في ظل إحساس متنامٍ بالإذلال القومي الروسي، لذا تبدو فكرة التخلص من بوتين كحل وحيد للأزمة فكرة غير واقعية لأن الرجل وإنْ كان يمثل رأس الحربة في مشروع استعادة المجد الإمبراطوري الروسي إلا أنه ليس المشروع نفسه، فالمشروع ظهر وتطور كرد فعل على التراجع التاريخي للقومية الروسية.
لذا، فإن الحل لا يكمن فقط في ذهاب بوتين، لكن في تراجع الروح القومية الروسية المتطرفة وتفكيك سرديتها التي تدور حول فكرة أن الغرب يستهدف تدمير روسيا وإنهاء وجودها… وهو أمر لا يمكن أن يتم عن طريق مزيد من إذلال روسيا كما يتصور كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بل عبر مزيد من التفاهمات والتطمينات والاستجابة لهواجس روسيا الأمنية بدلاً من تجاهلها.
فخطة إذلال مشابهة خلقت من ألمانيا كياناً عدوانياً مدمراً. وإذا استمر تكرار نفس “الوصفة” مع روسيا، قد نجد أنفسنا أمام سيناريو مماثل، حتى لو ذهب بوتين. فمرارة الهزيمة تتوارثها الأجيال.
رصيف 22
———————-

===================
تحديث 02 أذار 2022
——————–
“لقد رأيتُ هاتين العينين من قبل”: هكذا أحيا الغزو الروسي لأوكرانيا ذاكرتي السوريّة/ جود حسن
ليس من السهل تتّبع أخبار الحرب الروسية على أوكرانيا علينا نحن إذ جئنا من حربٍ ما زالت نيرانها مشتعلة في بلادنا.
تقترب، تقترب أكثر، تُلقي بملامحها على العدسة، مباشرةً وأمام مرأى الجميع. لقد رأيت هاتين العينين من قبل، النظرة الحادة الثابتة ذاتها، والسواد الغارق في فجوتي الوجه، تماماً تحت الحاجبين، الغبار الرمادي نفسه على الوجنتين، والأحمر الداكن المنزوي على طرف الوجه. هناك في البعيد، ترى خيالات لأبنية محطمة كلياً وشارع ارتمت عليه خطوات تائهة هاربة من موت وشيك.
خلال اللحظات الأولى لارتطام الصورة أمامي، حدث شيء غريب. انقسمت الشاشة أمامي إلى أقسام عدّة، عُرض في كل منها الوجه ذاته أو شبيه له، الخلفية نفسها أو ما يشبهها، كُتب على كل منها التاريخ والمكان، الماضي والحاضر، وأسماء بلاد أعرفها، منها ما شهد حرباً مماثلة. تجمّد جسدي في مكانه وحاولتُ أن أغمض عينَي، لكنني لم أستطع. حدّقتُ مطوّلاً في الصور، عادت تلاحقني.
الغزو الروسي على أوكرانيا أحيا ذاكرتي السوريّة التي لطالما افتخرتُ بقمع ما فيها.
أوكرانيا 2022- لقطة قريبة على مبنى مكوّن من أربع طبقات، رجل واقف يحدق فيها، ينتقل ببصره من طبقة إلى أخرى، هناك في الطبقة الثالثة يقع منزله، المبنى خالٍ من أي شيء. لا شبابيك فيه ولا أبواب ولا لون. داخله خارجه، منزل الرجل كذلك. على تلك الشرفة كان يشرب فنجان قهوته منذ يومين فقط، قبل أن تنهال عليه وعلى كل سكان المبنى قذائف الطيران الروسي. يطقطق برأسه نحو الأسفل، يسير بعيداً عن كل ما كان له.
في 24 شباط/ فبراير 2022، استيقظ سكان أوكرانيا على صوت صفارات الإنذار. هي الحرب اندلعت مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ الحرب الباردة.
أما نحن أبناء البلاد المنكوبة، فاستيقظت ذاكرتنا المظلمة. بات فعل الاستيقاظ عكسياً لما هو عليه، كأنّما نمنا فغرقنا في الكابوس وما زلنا نياماَ.
حلب 2015- ترى حيّاً كاملاً وقد دُمّر عن بكرة أبيه، خالياً من أي وجود بشري. وقفتُ حينها أمام أحد الأبنية، لا باب يحول بيني وبين الدخول إلى منازل مَن كانوا هنا قبل أن يبدأ قصف النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيّون مدينة حلب. المنازل جميعها انقلب داخلها خارجها. غرف النوم، غرف الجلوس، الحمامات، تمديدات الماء والكهرباء، الملابس وألعاب الأطفال والكتب والأوراق… كل شيء فيها تراه دون أن تطأ قدماك جوفها.
بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية على الأراضي السورية بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2015، بعدما طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعماً عسكرياً من موسكو. أسفر هذا التدخل عن مقتل آلاف المدنيّين في مناطق مختلفة من سوريا. واليوم، يبدو أن بوتين في غزوه القريب، أي أوكرانيا، وفي تدخّله عسكرياً في البعيد، أي سوريا والشرق الأوسط، يحاول جدّياً استعادة دائرته السوفياتية السابقة.
تختلف الحالة الأوكرانية عن الحالة السورية، ولكنها تشبهها بما تمثّله من تداعيات حرب كالدمار والقتل والتهجير ونشر الأخبار الزائفة. وإن كان خصم الشعبين مُشتركاً، إلا أن العدو الأساسي في سوريا كان ويبقى النظام السوري نفسه الذي طلب من الحكومة الروسية القتال معه ضد شعبه والخوض معه في معركةٍ غير عادلة من حيث القوة ضد فصائل معارضة مسلّحة، لم تتلقَّ سوى دعم محدود من الدول الغربية وغيرها. أمّا أوكرانيا، فتعرّض شعبها وحكومتها إلى احتلال روسي مباشر على أراضيها بقرار روسي فقط، ولخدمة النظام الروسي فقط. والجيش الروسي في الحالة الأوكرانية ليس أمام فصائل متفرّقة بل يواجه جيشاً منظّماً مدعوماً من فرقاء عدّة في الغرب.
في كلتا الحالتين، الحرب هي حرب، وضحيتها شعب لم يختر الحرب والعنف، خسر مسكنه وكل ما يملك وأُجبر على اللجوء إلى دول أخرى هرباً من الموت والإيذاء.
ليس من السهل تتّبع أخبار الحرب الروسية على أوكرانيا علينا نحن إذ جئنا من حربٍ ما زالت نيرانها مشتعلة في بلادنا. حتّى لو حاولت تفادي مواكبة الأخبار والتدقيق في كل صورة وفيديو، يبقى أنّك ستجد نفسك وقد غرقت في المشهد مُرغماً، دون وعي أو قصد. ترى بنفسك تآخي الوجوه وكل تفاصيل الصور والأحداث فيها وتبحر في رحلة المقارنة بينها وبين أحوالك.
تحت أغطية صوف متّسخة، ترى أجساداً متلاصقة، تحيط بها حقائب وأكياس متناثرة. إذا نظرت من زاوية أوسع، يمكنك أن ترى على مساحة واسعة قريبة من حدود بيلاروسيا وبولندا، أجساداً بشرية تشكّل معاً ضمن مجموعات متفرّقة كتلاً بشرية كثيفة محاولةً الحصول على شيء من الدفء في هذا البرد القارس، بعد أن منعتهم الكثير من تلك الدول من الدخول إلى أراضيها أو المرور منها، إن إلى ألمانيا (التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين) أو إلى غيرها. المتكدّسون فوق بعضهم والمنهكون القادمون من بلاد الحرب وعابرو طرق الموت، وجدوا أنفسهم في مواجهة نوع آخر من الظلم والعنف والضرب والذل من حرس الحدود، وذلك وسط تقاعس دولي رأى في استقبال هؤلاء خطراً على بلدان الحدود وثقلاً إضافياً هي غير مضطرّة لحمله.
نتحدّث عن آلاف المهاجرين العرب والأفارقة والآسيويّين الذين مرّت على وجودهم على الشريط الحدوديّ بين بلا روسيا وبولندا أشهر طويلة. بحوزتهم فقط ما استطاعوا حمله من أمتعة، والقليل من الطعام الذي وصلهم من طريق مجموعات ومنظمات إنسانية.
في المكان نفسه تقريباً، أي على الشريط الحدودي نفسه، آلاف من النازحين الأوكرانيين الهاربين من البطش الروسي والحرب في بلادهم، يحملون معهم أمتعتهم وما استطاعوا حمله معهم. المفارقة كانت أن فتح حرس الحدود الأبواب أمامهم، مع وصول عدد كبير من المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية لتقديم المعونة والمساعدة لهم، كما رحّبت بولندا بهم في أراضيها؛ في حين تستعد قافلات مدنية محمّلة بالمساعدات للتوجه إلى الحدود الأوكرانية لمساعدة اللاجئين الوافدين إلى الدول الأوروبية المجاورة.
وحدة الحال تجمع اللاجئين بصرف النظر عن المكان الذين أتوا منه. يجمعهم التيه والهرب من الموت والرغبة في النجاة وإرادة الحياة… غير أنّ معظم الدول الغربيّة كشفت، مقابل وحدة الحال هذه، عن ازدواجيّةٍ فجة في معاييرها الخاصّة بمعالجة هذه المسألة، فميَّزت بين اللاجئ وفقاً لهويّته وعرقه بدلاً من أن تعامل كل اللاجئين المتجمّدين من البرد القارس المعاملة نفسها.
بعيداً من كل الازدواج هذا، ومن عنصرية بعض دول المجتمع الغربي وإعلامه الذي يكرّس التمييز بين اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان من جهة واللاجئين الأوكرانيّين من جهة أخرى -على أسس لها علاقة بالعرق والدين واللون والمنشأ- الأكيد اليوم أنّه في الحرب واللجوء وحدهم اللاجئون مَن يعرفون معنى اللجوء حقاً، ومعنى الهرب من الموت، ومعنى الفقدان، ومعنى الشتات. يبقى أن في هذا الوقت العصيب الذي نعيشه، لا مكانَ فيه سوى للتضامن مع المظلوم واللاجئ، ولالتقاء الإنسان بإنسانيّته، وإنقاذ الأرواح العالقة في الداخل أو المعلّقة على الحدود.
في العاصمة الألمانية برلين، المدينة الحاضنة للتنوّع، ترى شوارع تعج بسكّان قدامى ولاجئين ومهاجرين من مختلف الجنسيات، يتظاهرون معاً تضامناً مع الشعب الأوكراني ضد احتلال بوتين لها. يقفون معاً في هذه اللحظة ضد الحرب، بمعزل عن أي حسابات أخرى.
أمّا أنا اللاجئ الفلسطيني السوري الذي استقبلته برلين قبل سبعة أعوام، فأجلس في منزلي الدافئ، أتابع كغيري ما يحدث في أوكرانيا، وسوريا، واليمن، والعراق… أخوض منذ بداية الاجتياح الروسي للبلد الأوروبي المجاور حرباً مع ذاكرتي والحاضر المحيط بي.
جلّ ما أراه الآن كلما أغمضت عينَي أو فتحتهما، مشاهد متسارعة مقتضبة، مدن مدمرة، وجوه مصدومة، الخصم نفسه يتبجّح بآلته العسكرية، إلى لاجئين متجمّدين على الحدود، جثث وأشلاء مترامية في الشارع، وكأن جسدي عاد إلى تلك الزنزانة المنفردة في فرع المخابرات الجوية العسكرية في دمشق، كما لو أنه في زمننا هذا لا مجال للتعافي من تداعيات الحرب مهما مرّ عليها الزمن… يبدو أن السلام، أينما لجأت، ليس بقريب.
هذا المقال نشر في صحيفة ديرشبيغل الالمانية
درج
————————-
أوروبا أخرى بعد الهجوم على أوكرانيا؟/ حازم صاغية
استخدم روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركيّ السابق، تعبيراً بليغاً في وصف أحوال العالم، وبلدان الغرب خصوصاً، بعد الهجوم الروسيّ على أوكرانيا. قال إنّ الإجازة من التاريخ انتهت.
الإجازة بدأت مع انهيار جدار برلين وسقوط المعسكر السوفياتيّ في 1989 – 1990. بعد ثلاثة أعوام، ظهر كتاب فرانسيس فوكوياما الشهير، وشاع تعبير «نهاية التاريخ» التي أنتجها، وفقاً له، انتصار نهائيّ حقّقته الديمقراطيّة الليبراليّة على نطاق كونيّ.
مذّاك استرخت أوروبا. الكاتب الأميركيّ روبرت كاغان وصف الأوروبيّين بأنّهم مقيمون على كوكب الزهرة ضدّاً على الأميركيّين المقيمين على كوكب المرّيخ. بالطبع لم تكن الإقامة الأخيرة سعيدة، ولا كانت عادلة دائماً، لكنّ الإقامة الأولى كانت، في معظم الأحيان، على سذاجة تتاخم البَلَه.
ومنذ 1999، تاريخ الظهور الأوّل لفلاديمير بوتين، انتصب في مواجهة تلك السذاجة خبثٌ مدجّج بعبادة القوّة من دون روادع، وبنزعة قوميّة وثأريّة تريد أن تنتقم للماضي السوفياتيّ الذي مضى.
بوتين، ما بين إحراقه الشيشان وإحراقه مدينة حلب، غزا جورجيا وأوكرانيا التي فصل عنها جزيرة القرم. تدخّل في أكثر من انتخابات أوروبيّة (وأميركيّة) دعماً لمتطرّفي اليمين واليسار. أوليغارشيّوه ومافياته تمكّنوا من استخدام المدن الأوروبيّة ملاذات وفراديس ضريبيّة لأموالهم القذرة. التهكير والتزوير والتجسّس استخدمتها موسكو على أوسع نطاق حتّى باتت الذراع الضارب لسياستها الخارجيّة…
أخطر من هذا أنّ بوتين وجد مؤيّدين ومقلّدين، في اليمين كما في اليسار، وفي مواقع رفيعة التأثير في بلدانها. الأميركيّ دونالد ترمب والبريطانيّ جيريمي كوربن والفرنسيّ جان لوك ميلونشون كانوا منهم. كلّهم، وبتفسيرات سياسيّة وآيديولوجيّة مختلفة، سعوا إلى إضعاف العلاقات الأوروبيّة – الأميركيّة. الإغراءات الماليّة لعبت دورها أيضاً: كاتب «الأوبزرفر» البريطانيّة أندرو راونسلي ذكّرنا في عموده الأخير ببعضهم: المستشار الألمانيّ السابق غيرهارد شرودر، وهو اشتراكيّ ديمقراطيّ، كان ولا يزال عضواً في مجالس إدارة بعض الشركات الروسيّة، بما فيها روسنيفت، النفطيّة المملوكة من الدولة. رئيس الحكومة الفرنسيّ السابق فرانسوا فيّون، وهو ديغوليّ كاد يرشّحه حزبه للرئاسة في الدورة السابقة، هو الآخر عضو في مجالس مماثلة لشركات بتروكيماويّة ونفطيّة تملكها الدولة. قادة سابقون في النمسا وفنلندا وإيطاليا شغلوا مواقع مشابهة ولم يستقيلوا منها إلاّ مع الغزو الأخير.
جاذبيّة بوتين ضربت بعيداً وقريباً. بعيداً، بات ميت رومني، المرشّح الجمهوريّ للرئاسة الأميركيّة في 2012، موضع سخرية وتهكّم حين تحدّث عن «روسيا كتهديد» في مناظرته الرئاسيّة مع باراك أوباما. شيء من تلك السخرية طال القطب الجمهوريّ الراحل جون ماكّين حين قال إنّه حين ينظر في عيني بوتين لا يرى إلاّ ضابط كي جي بي. أمّا قريباً، ففي هنغاريا التي لا تبعد كثيراً عن شدق التنّين، تباهى فيكتور أوربان مراراً بصداقته لبوتين وبإعجابه به.
خليط من الاسترخاء الذي أحدثه انتصار الحرب الباردة، والحروب الفاشلة في أفغانستان والعراق، واندفاع البيزنس والربح وانفلاتهما من كلّ عقال في ظلّ النيوليبراليّة، ورفع العتب بمقاتلة الفروع بدل الأصول، والإرهابُ أهمّ الفروع، وانسحابٌ أمام أنظمة كإيران، وتحويل معاناة السوريّين المُرّة إلى مسألة لجوء ولاجئين، وتباطؤ في حلّ مشكلات عالقة وعادلة كالمشكلة الفلسطينيّة…، كلّها صبّت على شكل مكاسب خالصة لبوتين.
اليوم، هناك إشارات تنمّ عن تغيّر في عموم العالم الأطلسيّ: أوروبا أشدّ صلابة ووحدة، تُسلّح الأوكرانيّين وتتسلّح. حتّى ألمانيا، ذات العلاقة المُشكَلَة مع التسلّح، تقرّر أن تنفق 2 في المائة من إجماليّ ناتجها المحلّيّ على الدفاع، بعدما أعلنت أنّها لن تشغّل خطّ نورد ستريم 2 للغاز. أميركا أيضاً أشدّ صلابة ووحدة، والعلاقة الأميركيّة – الأوروبيّة، التي دأب بوتين ومعجبوه في اليمين واليسار على إضعافها، في أحسن حال. أوربان صار يرى روسيا «دولة مارقة» ويطالب الأوروبيّين بالوحدة. وحتّى تركيّا إردوغان استعادت بعض أطلسيّتها بإعلانها أنّها ستمنع السفن الحربيّة لموسكو من عبور مضائق البوسفور والدردنيل للوصول إلى البحر الأسود. وفي داخل الحزب الجمهوريّ الأميركيّ بدأت ترتفع الأصوات التي تدين علاقة ترمب ببوتين وتكاد تتّهم الأوّل بالخيانة الوطنيّة.
وإذ تقول بلدان أوروبيّة من خارج الناتو والاتّحاد الأوروبيّ إنّها ستنضمّ إليهما، تلوح روسيا، التي تتهاوى عملتها، مطرودة من أجواء العالم ومن نظامه الماليّ والمصرفيّ. موانئ العالم وملاعبه ومسارحه تُحرّم كلّها عليها كما لو كانت كائناً مصاباً بالطاعون.
والحال أنّنا متى تذكّرنا أسماء قادة وقادة سابقين كترمب وأوربان وإردوغان وكوربن وميلونشون، واسترجعنا مصاعب بعضهم وتحوّلات بعضهم الآخر، جاز لنا أن نفترض تراجعاً في قدرة الشعبويّة على إنشاء الأحلاف وتوفير الدروع لصدر بوتين.
ومن يدري، فقد تتّجه الأمور بالأوروبيّين إلى تجديد ذاك الاندماج بين التقليدين اللذين عرفتهما بريطانيا في الأربعينات: التشرشليّة بوصفها الموقف الذي لا يهادن أنظمة الطغيان في أوروبا، والعمّاليّ الذي أنشأ دولة الرعاية لمواطنين يتكامل حرصهم على وطنهم مع حرص وطنهم عليهم.
وأوروبا هي البداية. ما يحدث فيها ليس بديلاً عن سياسات أخرى أشدّ تصلّباً في الدفاع عن الحرّيّة والعدل في سائر العالم. لكنْ يبقى أنّ قوّة أوروبا شرط لذلك ووعد به وضمانة له. فيها تبدأ العودة من إجازة التاريخ.
الشرق الأوسط
—————————–

تركيا وروسيا… العصا من الوسط/ بشير البكر
ازدادت على نحو ملحوظ، في الأيام الأخيرة، حركة السفن العابرة لمضيق البوسفور، الذي يفصل بين ضفتي مدينة إسطنبول، ويصل بين بحري مرمرة والأسود والأبيض المتوسط. ويمكن للمراقب أن يرى بالعين المجردة عبور السفن الحربية الروسية المزودة بالصواريخ وهي تتجه شمالاً نحو أوكرانيا.
وفي اليوم الثالث للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تركيا وافقت على إغلاق البوسفور بوجه السفن الحربية الروسية، ولكن أنقرة أعلنت أنها سوف تطبّق “اتفاقية مونترو” لعام 1936 بمرونة، لأنها حريصة على الحفاظ على العلاقات مع روسيا.
وتؤكد أنقرة التزامها بـ”اتفاقية مونترو”، وهو ما جدد إعلانه وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أمس الأول الاثنين، موضحاً أن الاتفاقية “تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفاً في الحرب، أما إذا لم تكن طرفاً في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها”. واستطرد: “الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود”. وأعلن أن بلاده أخطرت “جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا”.
وحتى قبل يوم الحرب التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أنه “لا يمكننا الاستسلام” بشأن روسيا أو أوكرانيا. لكن في اليوم التالي، عندما بدأت القوات الروسية بالتوغل في أوكرانيا، تحدث أردوغان بوضوح “إننا نجد العمل العسكري غير مقبول ونرفضه”، واعتبر الخطوة “مخالفة للقانون الدولي، وضربة قوية للسلام والهدوء والاستقرار في المنطقة… تركيا تقف ضد أي قرار يستهدف سيادة أوكرانيا”.
كما أعلن أردوغان، في مؤتمر صحافي الإثنين، أن بلاده “لن تتنازل عن مصالحها الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية”، مضيفاً “لذلك نقول إننا لن نتخلى لا عن أوكرانيا ولا عن روسيا”.
وأكد مواصلة بلاده مبادراتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأنها عازمة على استخدام صلاحياتها النابعة من “اتفاقية مونترو” بخصوص عبور السفن من المضائق، بشكل يحول دون تصعيد الأزمة.
ووافقت جميع الأطراف في البرلمان التركي رسمياً على أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا خاطئة، وأنه يجب ضمان وحدة أراضي أوكرانيا. وصدر بيان عن وزارة الخارجية التركية يعتبر العملية العسكرية للقوات المسلحة الروسية ضد أوكرانيا مرفوضة، و”غير مقبولة” و”انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”. وكانت قبل ذلك قد شجبت اعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين لوغانسك ودونيتسك.
صلاحيات تركيا وفق اتفاقية مونترو
إغلاق المضائق التركية أمام السفن الروسية أمر من صلاحيات أنقرة حسب “اتفاقية مونترو”، غير أن الإغلاق الكامل للمضائق غير ممكن، ولن يؤثر إلا على روسيا، لأن أوكرانيا ليس لديها سفن حربية تعبر من هناك.
وعلاوة على كل ذلك، لا يوجد إعلان رسمي روسي للحرب حتى الآن، وحتى لو حصل ذلك، لا يعتقد خبراء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ومنهم جيمس جيفري رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون، والسفير الأميركي السابق في العراق وتركيا، والمبعوث الخاص السابق للتحالف العالمي ضد “داعش”، أن تركيا ستفسر “اتفاقية مونترو” بهذه الطريقة، نظراً لحساسية العلاقات الروسية التركية.
ومن شأن ذلك أن يزعج موسكو سياسياً، كون روسيا تمتلك قوة كبيرة في البحر الأسود، بما في ذلك الغواصات، وسترى قرار الإغلاق موقفاً سلبياً من تركيا تجاهها. وعلى سبيل الرد يمكنها اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات، من إعادة النظر بـ”اتفاقية مونترو” إلى اتخاذ مبادرات لإلغائها.
وسيكون هذا الوضع مشكلة خطيرة بالنسبة لتركيا، التي ترى الاتفاقية على أنها نوع من صمام الأمان. ويمكن القول إن أنقرة سترغب في تجنب ذلك. وفي ضوء المواقف الغربية، سوف تبقى أنقرة لفترة أطول، تدير هذه المسألة بمرونة لا تضعها في مواجهة مع موسكو.
تركيا على تماس مباشر مع الأزمة في أوكرانيا، ومن أكثر الدول قرباً من الحريق الذي أشعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال غزو أوكرانيا. وعلى الرغم من أن قانون الجغرافيا والوضع الجيوسياسي يؤهلان أنقرة للعب دور رئيسي في تقرير مسار ومصير النزاع، فإنها تبدو وكأنها تريد الوقوف في الوسط، وذلك لاعتبارات وحسابات كثيرة.
وعلى عكس ألمانيا وفرنسا المشاركتين في عملية مينسك، تتمتع تركيا بتاريخ يمتد لقرون من المواجهة والتعاون مع روسيا. لقد كانت أنقرة مؤيداً صريحاً لوحدة أراضي أوكرانيا، ومنتقدة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ووضعت برنامجاً مهماً للتعاون مع كييف في مجال التكنولوجيا العسكرية.
وأصبحت أوكرانيا واحدة من أهم شركاء الدفاع لتركيا في السنوات الأخيرة، لأن أنقرة لا تستطيع شراء المنتجات التكنولوجية من الدول الغربية، فباتت كييف مورد محركات مهما جداً لأنقرة، وكانت المحركات أوكرانية الصنع مفضلة في طائرات “بيرقدار” بدون طيار.
ووقّع أردوغان اتفاقية مع أوكرانيا خلال زيارته إلى كييف مطلع فبراير/شباط الماضي، تقضي بإنشاء مصنع لتصنيع الطائرات من دون طيار التركية، وهو ما تسبب برفع حجم التجارة المتبادلة في صناعة الدفاع بشكل كبير بين البلدين.
وتوازى ذلك مع حفاظ تركيا أيضاً على علاقات فعالة مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة الزراعية والسياحة وكذلك بعض تقنيات الدفاع الرئيسية، وعلى سبيل المثال، شراء أنظمة الدفاع الجوي “أس 400” الروسية، التي كانت أحد الأسباب في زيادة تأزيم العلاقات بين أنقرة وواشنطن في العامين الأخيرين.
ومهما حصل لا تريد أنقرة أن تهدم جسورها مع موسكو، وتسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع كييف. ويتحكّم تشابك المصالح بين أنقرة وموسكو بالموقف التركي ويحدد مستوياته كافة. وهنا يمكن الحديث عن علاقات ثنائية مباشرة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية من جهة، ومن جهة أخرى مصالح إقليمية في سورية والعراق وآسيا الوسطى وليبيا ومنطقة القرم والبحر الأسود.
وتتفاوت هذه المصالح والعلاقات في لحظة الغزو الروسي لأوكرانيا، ما بين تقدم اقتصادي على مستوى التبادل والسياحة، ومراوحة سياسية تتجلى على نحو مثالي في سورية، التي باتت منذ عام 2016 أفضل “بارومتر” لقياس درجة حرارة العلاقات الروسية التركية.
وتفيد حسابات اقتصادية تركية بأن آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد التركي قد تصل إلى ما يقرب من 30 إلى 35 مليار دولار في المرحلة الأولى، ذلك أن قرابة 30 في المائة من السياح الذين يقصدون تركيا، يأتون من منطقة النزاع (20 في المائة من روسيا و10 في المائة من أوكرانيا)، والعائد المالي الذي يدرّونه يعادل 15-20 في المائة من إجمالي الدخل السياحي التركي، وبالتالي فإن الخسارة المتوقعة بسبب تضرر السياحة لهذا العام تقارب نحو 5 مليارات دولار.
وثاني الآثار الاقتصادية المباشرة تأتي من فاتورة النفط والغاز بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، ما يزيد أعباء الموازنة التركية بحدود 10 في المائة، مع العلم أن ثلث استهلاك تركيا من الغاز يأتي من روسيا.
الأمر الثاني هو أن تركيا هي واحدة من دول حلف الأطلسي القليلة التي لديها إمكانات عسكرية تشكل تهديداً للعمليات الروسية في البحر الأسود. وإذا قررت لعب دور بحري أكثر أهمية، فقد يتغير هذا التوافق مع روسيا. وحتى الآن لا تود أنقرة أن تتصرف من موقعها كعضو في “الناتو”، ومرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي منذ حوالي أربعة عقود.
وفي الحالين تبدو أنقرة بعيدة منذ سنوات عن هذين المحفلين، وتتعرض إلى معاملة تمييزية وتواجه سياسات تقوم على ازدواج المعايير، سواء من الولايات المتحدة التي تتحكم بقرار “الناتو”، أو من فرنسا وألمانيا اللتين تشكلان مركز الثقل في الاتحاد الأوروبي.
وبالنظر إلى هذا الوضع المتفجر، تقع على عاتق واشنطن مسؤولية التنسيق الوثيق مع أنقرة، وتجاوز الخلاف حول قضايا عدة كان لها تأثير سلبي على العلاقات مع واشنطن والأطلسي. أول خطوة ستكون تزويد الجيش التركي بالأسلحة التي تتحفظ عليها واشنطن منذ أعوام، ومنها طائرات “أف 16″، وتصحيح الخلل بين تركيا والأطلسي الذي لم يدعم أنقرة في المواجهات التي خاضتها مع موسكو في سورية، خصوصاً بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
بالإضافة إلى تغيير موقف واشنطن من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي هي على نزاع مفتوح مع أنقرة، وتدعمها الولايات المتحدة بقوة.
موقف محفوف بالمخاطر
يبقى الموقف التركي محفوفاً بمخاطر النزاع الروسي الأوكراني، وليس من الواضح إلى أي مدى تستطيع تركيا البقاء في منطقة الوسط، من دون أن تتأثر بالتداعيات الكبيرة اللاحقة السياسية والاقتصادية. وليس من السهل عليها أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وصديقاً لبوتين في آن، وستأتي لحظة يتوجب عليها أن تحدد المعسكر الذي تقف فيه في ظل الضغط الغربي على روسيا وسياسة عزلها عن العالم.
كما أن أنقرة سوف تتأثر حكماً بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب المقاطعة والعقوبات على النظام المالي والتجارة عبر الممرات وخصوصاً مضيق البوسفور. وبالتالي قد تكون سياسة الموقف الوسط واردة في الأيام الأولى من الأزمة، لكن حين تشتعل المنطقة، من الصعب تخيل نجاح “الناتو” في هذه الأزمة من دون دعم دبلوماسي على الأقل من تركيا.
وهناك من يرى لتركيا دور وساطة يمكن أن تلعبه بعد أن يحقق بوتين بعض المكاسب العسكرية على الأرض، ولم يستبعد ذلك المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المتخصص بتركيا، والذي بدأ حياته الدبلوماسية في أنقرة.
وقال إن “وساطة تركيا قد تكون مفيدة”، إذا أدت إلى امتثال أوكرانيا لاتفاقات مينسك. والرأي الغالب في الوسطين السياسي والإعلامي التركي هو أن تركيا دولة استراتيجية ومهمة للغاية في هذه الأزمة.
وتشير تصريحات أردوغان وإعلان وزارة الخارجية التركية إلى استراتيجية بنّاءة للغاية. تدين أنقرة موسكو لانتهاكها أراضي أوكرانيا ومهاجمتها دولة على أراضيها، بينما تحاول أيضاً الحفاظ على الحوار مع الكرملين، ويقولون إن تركيا هي الدولة الوحيدة في “الناتو” التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كلا الطرفين، وهذا هو السبب في أن تدخل أردوغان كوسيط في هذه الأزمة، قد يكون مفيداً في جلب موسكو إلى طاولة الحوار.
العربي الجديد
—————————-
بوتين… وجيل جديد من «فتيان الزنك»/ موفق نيربية
في تعريف أوكرانيا، تذكر المراجع أنها بلد معروف بطبيعته المتنوعة الجميلة، وبتراثه وتقاليده الملوّنة، وبجمال نسائه… وبكارثة نووية اسمها تشيرنوبل. هذه البلاد الآن في مهبّ الريح، لن يحميها – نسبياً- إلّا وزنها من احتمالات داكنة في المستقبل، بسبب مغامر يقود الدولة العظمى الثانية في العالم، من حيث قدرتها على تحطيم غيرها، أو تحطيم الكوكب.
يجادل باحثون مهمّون في أن ما حدث كان يمكن تلافيه، لو قامت الإدارة الأمريكية بالضغط من أجل تطبيق متطلبات «اتفاق مينسك- 2» فبراير/ شباط 2015، التي يريدها بوتين من كييف، بدلاً من الاسترخاء والاستمرار في لعبة الجزرة والعصا. وما أراده في الاتفاق؛ وحتى في «اتفاق مينسك – 1 أيلول/سبتمبر 2014 الذي سبق الثاني بخمسة أشهر فقط؛ هو تعديل دستوري يقر باللامركزية، ويزيد من صلاحيات الجمهوريتين موضوع النزاع، إضافة إلى العفو العام، وتبادل الأسرى مثلاً، إضافة إلى ذلك أيضاً، أراد بوتين تأخير وقف إطلاق النار لعدة أيام لمعرفة مصير منطقة محاصرة.
ورد هذا الرأي الناقد في دراسة لمعهد راند، ولدى باحث مهم اسمه شراب، لكن ما بدا كأنه تلكؤ من الإدارة، استمر على المنوال ذاته. وكانت الحكومة الأوكرانية قد قامت بتعديل مقدمة الدستور بعد اتفاق مينسك على عكس متطلباته، بشكل يؤكّد المصير الأوروبي والأطلسي لأوكرانيا… وحتى الساعات الأخيرة قبل الهجوم الروسي، بقي الغرب رافضاً لطلب الروس تحييد أوكرانيا وعدم ضمها للناتو، إيماناً بمشروعية حقها بذلك الطلب حين تتقدّم به. هل كان ذلك التنازل – لو حصل – سيحمي أوكرانيا من بوتين؟ لا يمكن تأكيد ذلك أبداً، وهو لو حصل، ربّما كان سيؤخر الغزو لفترة ما. وقبل ذلك بزمن قال جنرال روسي معلّقاً على الاتفاقات، إنه لا يعنيه ربح الدونباس مع خسارة أوكرانيا! تصريحات بوتين نفسه، وميدفيديف بطريقة أكثر وقاحة، عبّرت عن مثل ذلك سابقاً. جرى الحديث عن أن أوكرانيا بلد «غير متوازن» بين شرقه وغربه، وبين شماله وجنوبه، بين أوكرانيته وروسيته. في إسار النزعة الروسية وعنجهيتها، يمكن التنازل جزئياً، في ما يخص دول البلطيق الثلاث، التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق، وكذلك الدول الآسيوية بطريقة أخرى؛ ولكنّ أوكرانيا وبيلاروسيا موضوع خاص تتداخل مساراته مع روسيا، وضمنها أيضاً. هما الأختان الصغيرتان اللتان لا يمكن التنازل عن حضانتهما أبداً. بيلاروسيا مضمونة عن طريق ديكتاتور فاسد وتافه، وتبقى أوكرانيا ذات الطموحات العالية الأوروبية – الغربية- الديمقراطية… وموضوعها لا يمكن انتظار الموافقة أو الصمت الدوليين عليه، وأصبح ذلك مستحيلاً، يمكن تهيئة الأجواء إلى الحدّ الممكن وحسب.
استقر الوجود الروسي في سوريا وشرق المتوسط إلى حدّ كبير، وأمكن تدريب الأمريكيين والأوروبيينّ على قبول ذلك، إضافة إلى القبول بحصة روسية ثابتة في المسار السياسي والواقع الجغرافي هناك. واستطاعت روسيا تأمين علاقة مصالح متبادلة مع إسرائيل. كما أنها نجحت في الاستفادة من التعارض التركي الأمريكي، ومن الثغرة التي انفتحت ويمكن المرور منها إلى تردّد الأتراك في التزاماتهم الأطلسية عند استحقاقها، ذلك الاتّجاه كلّه، مع الغنيمة في شبه جزيرة القرم، ينبغي تأصيله وتوصيله مع روسيا ضمن أوروبا، للوصول إلى الهدف الأهم: إنهاء قواعد النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة، قبل استكمالها وتكريسها، وفرض قواعد نظام جديد تعود فيه روسيا إلى مقعد الاتّحاد السوفييتي الفارغ. ربّما لن يفشل ذلك المشروع بشكل كامل، لكنّه غالباً لن ينجح أيضاً. فعلى ما يبدو من الملامح حتى الآن؛ وموسكو لا تستجيب ولا تبدي من المرونة حدّها الأدنى اللازم؛ سوف ندخل في مرحلة» قانون القيصر» الأوكراني، بعد أن كنّا في مرحلة قانون قيصر السوري، من دون أل التعريف. وربّما لم يتمكن باحثو معهد راند من الإحاطة بهذه التفاصيل وآفاقها في دراستهم المشار إليها أعلاه. سوف يتأثّر الاقتصاد العالمي إضافة إلى حالته وحالة الاستقرار السياسي والأمني، مع كلّ ما عانى منه بسبب جائحة كورونا حتى الان. فمنطقة الصراع بذاتها تنتج نسبة مهمة من قمح وذرة العالم، كما أن حالة من الخلل والانزياحات، سوف تعمّ إلى فترة حتى تكون العودة إلى وضعية أكثر استقراراً ممكنة. ولكن ما يعنينا هنا هو تأثّر روسيا لاحقاً، بعد أن قيل إن القيمة المالية للاستثمارات فيها قد خسرت ثلث قيمتها في يوم الغزو الأول وحده في أسواقها المالية، وتبع ذلك خسارة الروبل ما يقارب نصف قيمته. سوف يكون الوضع كما كان في السابق، تحت عدسة مكبّرة. فحتى الآن، كانت نقطة قوة اقتصاد الاتحاد الروسي في النفط والغاز، ونقطة ضعفه الأهم في العقوبات التي كانت مفروضة عليه. وما زال الغرب بحاجة إلى الصادرات الروسية في النفط والغاز، حتى أن جميع العقوبات التي فُرضت على روسيا في البداية، راعت هذه المسألة وتسهيل استمرار تدفق هاتين المادتين، وتيسير مستلزماتهما المالية. ومن جانب آخر، أخذت حزمة العقوبات تكبر وتكبر ككرة الثلج؛ حتى أنهت كلّ التحفظات والترددات الأولية؛ وسوف يتضاعف مقدار تأثيرها على الاقتصاد الروسي، ومن ثمّ على الجوانب الأخرى: الاجتماعية والسياسية خصوصاً. سوف تبدأ بذلك مرحلة عضّ أصابع مريرة غير معلوم مداها وامتدادها، هي بالتأكيد سوف تعرقل تحقيق الهدف الروسي الأكبر، وتعديله للنظام الدولي الراهن، وربّما لن يكون من السهل بعد الآن إعادة السياق إلى حالته قبل بداية الاجتياح.. هذا يعني أن إمكانية تراجع بوتين عمّا قام به أصبحت صعبة جداً. نعلم جيداً أن حروب بوتين و»انتصاراته» في البحر المتوسط، وسوريا خصوصاً، قد فتحت الباب إلى حربه على حدوده وحدود الغرب الأوروبي والأطلسي، ولكن الذي لا نعلم عنه الكثير بعد، هو الباب الذي سيفتحه غزو أوكرانيا على الاتفاق النووي، وعلاقة روسيا مع إيران وتركيا وإسرائيل، وعلى الغزوات الروسية في منطقتنا عموماً. ونسمح لأنفسنا أن نسأل أيضاً عن آثار ذلك كلّه على المسألة السورية. ها هو غير بيدرسون- الممثل الأممي للمسألة السورية – قال قبل غيره شيئاً عن ذلك: سوف تغدو العملية السياسية في سوريا أكثر صعوبة، مع إعلانه عن انعقاد اللجنة الدستورية المصغرة، بعد الاجتماعات في جنيف، بعد ثلاثة أسابيع من الآن. مع أنه ليس من الضروري أن تكون تصريحات بيدرسون» المتشائمة» مصدر قلق للسوريين الحائرين والمشوشين حالياً إلى حدّ كبير. وبالأساس، أصبحت العودة بالزمن إلى الوراء مستحيلة، وقد بدأت مغامرة بوتين في أوكرانيا بالغوص في حرب لن تتوقّف بسهولة على الإطلاق. ولا يبدو الأوكرانيون عاجزين عن تحويل هزيمتهم – عند حدوثها- إلى معركة تحرير لطالما اعتادوا عليها في تاريخهم اللافت في هذا المجال.
منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، اتهمّت الروائية البيلاروسية- المولودة في أوكرانيا والروسية الثقافة – سفيتلانا أليكسيفتش روسيا بغزو أوكرانيا، مع معارك الدونباس يومذاك، بعد أن كانت قد فازت بجائزة نوبل عن أعمالها الروائية التي تصوّر الحياة في الاتحاد السوفييتي سابقاً. وكان من أجمل نتاجاتها رواية توثيقية بعنوان «فتيان الزنك» ترصد مصائر وحياة من قضى من السوفييت في حربه في أفغانستان، وعاد في تابوت من التوتياء، يلمع تحت الشمس. يقول العديد من الباحثين في انهيار الاتّحاد السوفييتي وكتلته الاشتراكية، أن تلك التوابيت التي كانت تتوارد بالطائرات من أفغانستان، لعبت دوراً خفياً وكبيراً في تهيئة الشعب لعملية التغيير الدراماتيكية، التي تتالت حتى انهيار الاتحاد السوفييتي.. ويبدو أن بوتين؛ بعد أن تجنب في حربه على السوريين الالتحام المباشر معهم، واختار طريق القصف الكاسح عن بعد؛ لم يحسب حساباً لاحتمال طول الحرب الأوكرانية، وخسائرها؛ ولا لدرجة العقوبات اللاحقة وحجمها؛ ولا لبسالة الأوكرانيين في دفاعهم عن مصائرهم؛ ولا لشعبه الذي لن يصمت… وربما نكون في لحظة انعطاف في التاريخ، لن يمنعه تهديد بوتين النووي، الذي ربّما هو دليل فشل على الأرض، وعلى تعرّض الاستراتيجية الهادفة إلى استعادة المركز الدولي القديم لنكسة كبيرة.
كاتب سوري
القدس العربي
————————–

سوريا الى أين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ؟/ عمار ديوب
العالم بعد غزو أوكرانيا، ليس هو ذاته قبل هذه اللحظة. بوتين يعلن رفضه القاطع لاقتراب الناتو إلى حدود روسيا، وأن أوكرانيا ليست دولة من أصله، وما أعطاه لينين لها من استقلال لن يستمر. ليس الأمر هكذا فقط؛ بوتين يرفض كذلك التحاق أوربا الشرقية بحلف الناتو، ويريد إعادة الأخيرة إلى ما قبل 1997. المعركة في أوكرانيا، وحدت حلف الناتو والإدارة الأمريكية، وأرسلت الأخيرات قوات عسكرية لتعزيز دول البلطيق اّلثلاثة، وبولندا، وفرضت أوربا وأمريكا عقوبات اقتصادية جديدة، وسيتم قطع إمدادات الطاقة بين روسيا وأوروبا، وإخراج روسيا من نظام السويفت، وعزلها عن النظام المالي العالمي.
أكدّ بوتين، ومن أجل تقوية موقفه شعبياً، أن أوربا وأمريكا كانت ستفرض عقوبات جديدة؛ بغزوٍ أو بدونه. إذاً غزو أوكرانيا لم يوقفه التهديد بالعقوبات، وستتأزم العلاقات بين روسيا وأمريكا وأوروبا أكثر فأكثر؛ سورية ستتأثر بذلك، فهي متروكة دون أيِّ حلٍّ سياسيٍّ منذ 2018، أقلّها، حيث فرضت روسيا سيطرة على مناطق أوسع، وكانت تحت سيطرة الفصائل، ولصالح النظام، بينما انحصرت الفصائل التابعة لتركيا وهيئة تحرير الشام في جيوب حدودية؛ وظلّت قسد تحوز على مناطق واسعة شرق وشمال سورية. تأزم العلاقات بين الدول أعلاه، سيعني أن سورية وُضِعت بثلاٍجة أكثر إحكاماً وصقيعاً، وأوضاعها متروكة إلى مزيدٍ من التأزم الاقتصادي والاجتماعي، وهناك محللون يؤكدون أن الخطوة التالية في سورية تقسيمها إلى ثلاثة مناطق. وبغض النظر عن المبالغة، فهناك حدود مرسومة للأراضي السورية، وتسيطر عليها وتحميها، كل من تركيا وروسيا وأمريكا، وضمناً إيران.
إن فرض عقوبات جديدة على روسيا، سيعني أن الأخيرة ليست بوارد التفاضل بين أوكرانيا وسورية، وجاءت زيارة وزير الدفاع الروسي، لتقول بأن بلاده ليست بوارد أية “مداكشات” هنا وهناك، وأنها تريد إرساء نظاماً دولياً متعدد الأقطاب، وستحاول استعادة مجد الاتحاد السوفيتي سابقاً، وسورية درّةهذه الاستراتيجية على البحر المتوسط، وبالتالي ستستمر روسيا بإشاحة النظر عن القرارات الدولية التي تنصف الشعب السوري، ومتابعة العمل بمسارات الاستانة، وسوتشي، واللجنة الدستورية، ومحاولة تطويق قسد، والمناطق المضطربة تحت سيطرة النظام، كالسويداء أخيراً.
مشكلة سورية أنها أصبحت ورقة بيد الروس، ولا توجد دولة بمقدورها تجاوز شروط الاحتلال الروسي لسورية، وأيضاً، ليست الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بوارد التنازل لروسيا عن سورية كاملة، ولكن ليسوا بعجلة من أمرهم للبحث عن تسوية أيضاً. حتى أوكرانيا، التي يرى بعض المحللين أن أوروبا وأمريكا سارعتا إلى نصرتها، ليسوا بمنصفين؛ فأكثر ما فعلته القوتان السابقتان، هو دعمها ببعض الأموال والسلاح، وفرض العقوبات، وهو ما سخر منه الرئيس الأوكراني في قمة ميونيخ للأمن قبل عدّة أيام.
التأزم الجديد عالمياً، لا يمنع إمكانية الوصول إلى صفقات سياسية، ولكنها حالياً غير واردة بخصوص سورية أو أوكرانيا، والغزو الروسي، قد يشيح النظر لوقتٍ غير قصير عن أوضاع سورية. الآن هناك رفض من مؤسسات هيئة الأمم المتحدة للغزو؛ والروس قالوا إنها ليست دولة، أو أصبحت دولة بفضل الثورة البلشفية، وستعود إلى الحضن الروسي. هذا الوضع يدفع للقول إن سورية أصبحت من جديد بوضعية معقدة لغاية، فأوضاعها تزداد سوءاً، وأزمتها الاقتصادية كارثية بكل المقاييس، واحتجاجات السويداء، لن تكون النهاية، وستندلع احتجاجات جديدة أخرى؛ فهناك ارتفاع يومي للأسعار في الأسواق، وفي المناطق الثلاثة، وهذا يعني أن احتجاجات قادمة لا محالة.
الدول المتدخلة في سورية مشغولة بأوكرانيا، والتأزم بينها يجمدالبحث عن صفقة، فهل لدى السوريين بدائل عما هم فيه من انقسامات وتفكك واحتلالات؟ النظام ليس بوارد التفكير بأيِّ تغيير؛ فهو يعتقد أن روسيا وإيران طوع بنانه، رغم خضوعه لهما، وستعيدان له كل سورية، وليس من مشكلة إن لم تعد بعض المناطق. مشكلته أن حلفائه لا يمتلكون إمكانيات لدعم مدنه، وسياساته قائمة على الفساد والنهب، وكذلك غير قادر على إيقاف ما ذكرنا، ويُصدِرُ يومياً ضرائب جديدة، ويتفنن في سرقة أموال السوريين، في الداخل وعبر الحوالات، وعبر قوانين تخص كل عمليات البيع والشراء، ورفع أسعار الوقود والخبز، وإلغاء الدعم، وسواه كثير؛ وفي ذلك يقول رئيس وزراءه، أن لا خيار أخر لدى النظام، وسياسات اللبرلة والخصخصة لن تتوقف.
أيضاً المعارضة، ليست بوارد التغيير والتقارب بين أطرافها؛ فقسد لها مساراتها، والائتلاف الوطني له مساراته، وهيئة تحرير الشام تابعة بقضها وقضيضها للأتراك، وتناور لتكون تحت الرعاية الأمريكية تارة أو الروسية أو الإيرانية، ولن نتكلم عن إمكانية أن تكون قيادات رئيسية فيها تابعة لإيران أو للنظام السوري. المقصد هنا، أن الأطراف السورية، جميعها، ولأسبابٍ كثيرة ليست بوارد التقارب فيما بينها. ندوة الدوحة الأخيرة استثنت الأكراد أو تفكيك الائتلاف، وندوات تعقدها قسد في هذه العاصمة الأوربية أو تلك، ولنقل تشارك فيها، وأيضاً لا تمثيل للائتلاف فيها، وكذلك ليس من لقاءاتٍ سرية بين هذه الأطراف، وبحثاً عن صفقة تجمع مناطق قسد والفصائل التابعة لتركيا. تشكل الخلافات بين تركيا والإدارة الأمريكية بخصوص الوضع في سورية، وفي تضارب المصالح بين الدولتين مانعاً لإيجاد صفقة ما بين الأطراف السورية، وعدا ذلك، فالموقف التركي المتشدد ضد الأكراد، وليس فقط قسد ومسد، يمنع ذلك، سيما أن قسد تحالفت بقوة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن تتخلى الأخيرة عن قسد، وإن كانت أيضاً لا توافقها على رؤاها المختلفة، ودائما تطالبها بالحوار مع بقية الأطراف الكردية، وأيضاً تضغط عليها لتتخلى لتركيا أو روسيا عن بعض المناطق، وهذا متعلق بتدوير الزوايا بين كل من الإدارة الأمريكية وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل.
هيئة تحرير الشام خاضعة لتركيا، والأخيرة تترك لها التفنن بأشكال السيطرة على ملايين السورين، الذين تحت سيطرتها، وكذلك روسيا والإدارة الأمريكية لا تفعل شيئا حيالها، وكأنّ الجميع يترك للهيئة أن تحكم وتسيطر وتنهب، وليقول لبقية السوريين، اصمتوا، فالبديل عن النظام أو قسد أو الفصائل أسوأ، إنها هيئة تحرير الشام، وربما عودة داعش تأتي بهذا الإطار.
سورية متروكة يا سادة لقوى الأمر الواقع، وهؤلاء لا يجدون حلاً يتوافقون عليه؛ وأيضاً، ليس من مبادراتٍ شعبية، أو سياسية مستقلة، وقادرة على الوصول إلى ذلك الحل وفرضه. الاحتجاجات قد تندلع من جديد، وروسيا ستتشدد ضدها، فهي لن تسمح بعدم الاستقرار في مناطقها. إن روسيا، ستفاوض أوربا وأمريكا بأوراق جديدة، منها سورية ومنها شرق أوكرانيا او أوكرانيا بأكملها، وهناك شروطها على أوروبا وأمريكا بما يخص أمنها القومي، ولكن غياب المصالح الأمريكية حالياً بالتفاوض وربما رغبة أمريكا بتأزيمٍ أكبر للعلاقات الأوربية الروسية؛ وضمن ذلك، إن سياسة فرض العقوبات على روسيا لا تبشر بخيرٍ قريبٍ على سورية أو أوكرانيا؛ ربما ليس خاطئاً القول إن أقطاباً جديدة تَفرض نفسها عالمياً على جثة سورية والسوريين، وهذا، كما قلت قد لا يمنع التفاوض، ولكنه أيضاً غير مطروحٍ حالياً بين الدول العظمى، والمتدخلة في سورية وأوكرانيا أيضا؛ هذه هي أوضاع العالم وسورية بأسوأ مكانٍ فيه.
————————————
لماذا كلّ هذا الربط بين سورية وأوكرانيا؟/ مروان قبلان
رغم أنّه ظاهرياً لا رابط بينهما، لكن لا توجد أزمة عالمية معاصرة ارتبط مصير سورية ومستقبلها بها كما أزمة أوكرانيا، فسورية دولة عربية، متوسطة الحجم، محدودة الإمكانات، تقع على الساحل الشرقي للمتوسط، لا ينبغي أن تثير اهتماماً كبيراً في ما وراء جوارها الإقليمي المباشر، في حين أنّ أوكرانيا تمثل جزءاً من العالم السلافي، تقع شرق أوروبا، على حدود الاتحاد الروسي، وتفصل بينه وبين أوروبا الأطلسية. مع ذلك، ارتبط مصير البلدين بطريقةٍ غير مسبوقة. قبل سقوط نظام فيكتور يانكوفيتش، في فبراير/ شباط 2014، وانتقال أوكرانيا الى المعسكر الغربي، كان الاهتمام الروسي بسورية محصوراً بمحاولة منع تكرار سيناريو ليبيا فيها (وهو سيناريو لم يكن وارداً على أية حال، في ظل مسعى إدارة الرئيس أوباما الخروج من العراق والمنطقة بأيّ ثمن، وتوجّهه إلى التفاهم مع السعودية وإيران بشأن مستقبلها). وعليه، اقتصر التدخل الروسي هنا على تقديم دعم سياسي للنظام في دمشق، خصوصاً في مجلس الأمن. كما حاولت روسيا لعب دور في التوصل إلى حلّ يمنع حصول تغيير عميق في بنية النظام السوري من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، وأقرّه مجلس الأمن في قراره رقم 2118 لعام 2013، وتضمّن، إلى جانب تسليم النظام سلاحه الكيميائي، بعد مجزرة الغوطتين في أغسطس/ آب 2013، إطلاق عملية سياسية، بدأت أواخر يناير/ كانون الثاني 2014، وعرفت في أدبيات الأزمة السورية بـ جنيف 2. في هذه اللحظة تحديداً، اندلعت أحداث الميدان في كييف وانتهت بهروب يانكوفيتش. اعتبرت روسيا سقوط أوكرانيا في حضن الغرب مجدّداً، بعدما استردتها منه، عبر عودة حلفائها في “حزب المناطق” إلى السلطة في انتخابات عام 2010، ضربة كبيرة لمساعي استعادة مكانتها، أقله على المسرح الأورو- آسيوي. وعليه، ردّت روسيا بضم القرم، ففرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات، اعتبرها الرئيس بوتين إهانةً، ردَّ عليها في سورية.
تمثلت أولى انعكاسات الصراع الروسي – الغربي بشأن أوكرانيا على سورية في فشل مفاوضات جنيف2، إذ طلبت روسيا من النظام التشدّد في مواقفه، ثم ذهبت باتجاه إخراج مسار جنيف كلياً عن مساره، بتأييدها إجراء انتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران 2014. قبل ذلك، كانت روسيا، بعكس إيران، تعارض إجراء أي انتخابات رئاسية في سورية، إلّا في إطار حلّ سياسي متفق عليه بين النظام والمعارضة. استمر التشدّد الروسي في المسألة السورية بالتوازي مع تصاعد التوتر في العلاقة مع الغرب خلال الحرب التي اشتعلت في إقليم دونباس، ودعمت روسيا فيها استقلال إقليمي لوغانتسك ودونيتسك اللذين تقطنهما أقلية روسية كبيرة، وأمدّتهما بالمرتزقة والسلاح. وفي عام 2015، استغلت موسكو استفحال مظاهر فشل السياسة الأميركية في العراق وسورية، للتدخل عسكرياً في الأخيرة. أراد بوتين استخدام نتائج حربه في سورية في إطار مقايضةٍ مع الغرب لاستعادة أوكرانيا، لكنّ إدارة أوباما رفضت قطعاً المقاربة الروسية.
لم يكن أوباما يلقي بالاً للصراع في سورية، وكان ينظر إليه جزءاً من صراع “تاريخي” سنّي شيعي، لا حليف مفضلا لأميركا فيه، أما أوكرانيا فصارت أداته الرئيسة في احتواء طموحات روسيا استعادة مكانتها العالمية. لكنّ بوتين لم يصبر على تجاهل الغرب تدخله في سورية، فعمد إلى إغراقه بموجات من اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم القصف الروسي. واعتباراً من عام 2018، أخذ يستخدم مناطق المعارضة في شمال غرب سورية أداة للضغط على تركيا في ملفات عديدة متشابكة بينهما، ومنها أوكرانيا التي زودتها تركيا، أخيراً، بطائرات مسيّرة استدعت احتجاجاً روسياً، وهو نمط من السلوك الروسي يتوقع أن يستمر إذا اتخذت تركيا إجراءات أقوى بخصوص الحرب في أوكرانيا، مثل تفعيل معاهدة مونترو لعام 1936، والتي تنصّ على تقييد حركة السفن الحربية في البحر الأسود في حال اندلاع حرب.
خلاف ذلك، سوف يتضرّر السوريون، سواء في مناطق النظام أو المعارضة، من ارتفاع أسعار الطاقة والقمح بفعل الأزمة الأوكرانية، وسوف يرتب ذلك أعباء إضافية عليهم فوق التي يعانون منها أصلاً. أما العملية السياسية فالأرجح ألّا تتأثر كثيراً، لأنّه لا توجد في الأصل عملية سياسية.
العربي الجديد
————————-

بوتين ضد لينين: عن النسخة البوتينية لتاريخ روسيا وأوكرانيا
إيزاك شوتنر
أجرى الصحفي الأمريكي إيزاك شوتنر هذه المقابلة مع سيرغي بلوخي بعد حديث فلاديمير بوتين المتلفز يوم الإثنين 21 شباط، والذي أنكر فيه وجود هوية أوكرانية مستقلة عن روسيا. صدر الأصل الإنكليزي في مجلة ذا نيويوركر بتاريخ 23 شباط، أي قبل الإجتياح الروسي بيوم، تحت عنوان: Vladimir Putin’s Revisionist History of Russia and Ukraine.
أعلن فلاديمير بوتين صراحةً عن قناعته بعدم وجود أساس تاريخي لاستقلال أوكرانيا، ووصل به الأمر إلى التصريح، يوم الاثنين 21 شباط، بأن أوكرانيا الحديثة هي «صنيعة روسيا بالكامل». تعبّر تصريحات بوتين عن استيائه من الزعماء الأميركيين والأوروبيين بسبب ما يراه سحب أوكرانيا غرباً منذ نهاية الحرب الباردة. ولكن ما يكمن وراء غضبه هذا هو رفض مشروع سياسي تجسد في الاتحاد السوفييتي. لسنوات، شكّك بوتين في شرعية الجمهوريات السوفييتية السابقة، زاعماً أن لينين قد زرع «قنبلة موقوتة» بمنحه هذه الجمهوريات حق تقرير المصير في سنوات الاتحاد الأولى. يبدو بوتين في خطاباته وكأنه يحاول إعادة الزمن إلى الوراء، لا ليرجع به إلى أيام الاتحاد السوفييتي في ذروته، بل إلى سنوات الإمبراطورية الروسية القيصرية.
تحدثتُ مؤخراً مع سيرغي بلوخي، البروفيسور المتخصص في تاريخ أوكرانيا وأوروبا الشرقية في هارفارد، وصاحب كتاب بوابات أوروبا، الذي يروي تاريخ نشوء الهوية الأوكرانية (ويصدر له قريباً كتاب جديد هو ذرّات ورماد: تاريخ الكوارث النووية حول العالم). ناقشنا أصول المخاوف الروسية بشأن اللغة والهوية الأوكرانيتين، والرد الممكن من الأوكرانيين على الغزو الروسي، وما يقوله لنا خطاب بوتين عن العلاقة المعقدة بين الدولتين.
إلى أي مرحلة تاريخية يعود نشوء شكل من الهوية الأوكرانية يمكننا التعرف إليه اليوم، حسب رأيك؟
تتوقف الإجابة على المكوّن الذي تتحدث عنه من مكونات الهوية. إذا كنت تقصد اللغة، فهي قديمة جداً. وإذا كان المقصود المكوّنات الدينية للهوية، فهي تعود إلى أكثر من ألف سنة. ولكن أول مشروع سياسي أوكراني حديث يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، كما هو الحال في العديد من المجتمعات. المشكلة التي واجهتها أوكرانيا هي أنها كانت مُقسّمة بين قوتَين: روسيا القيصرية وإمبراطورية النمسا-المجر. ولقد تنبّهت روسيا مبكراً إلى الخطر الذي يمثله وجود لغة أوكرانية منفصلة وأدبيّة على وحدة الإمبراطورية الروسية. لذلك، اعتباراً من ستينيات القرن التاسع عشر، جرى لأكثر من أربعين عاماً منع النشر والطباعة باللغة الأوكرانية، وهو ما حدّ من تطور اللغة الأدبية الأوكرانية. كان ذلك، إلى جانب الانقسام بين الإمبراطوريتين، عاملاً مساهماً في هزيمة الأوكرانيين الذين حاولوا نيل استقلالهم خلال الحرب العالمية الأولى وخلال الثورة، وهي المرحلة التي حاول فيها أبناء جنسيات أخرى تحقيق الهدف نفسه، وبعضهم نجح في ذلك.
ما التهديد الذي مثّلته الهوية الأوكرانية، ولا سيما اللغة، لروسيا؟ هل كانت المسألة سلوكاً إمبريالياً تقليدياً ناجماً عن عدم الثقة بالأقليات ولغاتها، والكراهية تجاهها؟
كان الروس يشاهدون ما يجري في أوروبا في تلك المرحلة، ولاسيما في فرنسا، حيث نشأت فكرة خلق لغة واحدة من لهجات أو لغات متعددة، وهو ما اعتُبِر مرتبطاً بوحدة الدولة. وهذا يعني أن الفكرة عالمية. أما الملمح المحدد والمرتبط بما يجري اليوم هو فكرة وجود أمة روسيّة، أو سلافيّة، كبيرة واحدة، لعلها تضم عدة قبائل، ولكنها أمّة واحدة. هذا هو المثال من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والذي يتمثله بوتين اليوم حين يصرح بعدم شرعية أوكرانيا كأُمّة. ثمة اتصال مباشر بما يجري اليوم.
كتبتَ مؤخرًا: «تأسس الاتحاد السوفييتي بين 1922 و1923 كدولة شبه فدرالية، عوضاً عن دولة مركزية موحدة، ليستوعب أوكرانيا وجورجيا، الجمهوريّتين الأكثر ميلاً للاستقلال». هل لك أن تتوسع في هذا؟
سيطر البلشفيون على معظم أراضي الإمبراطورية الروسية بالاعتراف، على الأقل شكلياً، باستقلال الجمهوريات المختلفة التي كانوا يضمونها. وحتى عام 1922، كانت أوكرانيا دولة مستقلة. حين وقّع البلشفيون معاهدة رابالو مع ألمانيا عام 1922، طرح بعض الأوكرانيين أسئلة حول أحقّية ممثّلين روس بتوقيع الاتفاقيات نيابة عنهم، ما أوصلهم إلى الإيمان بوجوب إقامة دولة موحدة. اقترح ستالين الوحدة بين الجمهوريات المختلفة المنضمة إلى الاتحاد السوفييتي، أما لينين فاتخذ صف الأوكرانيين والجورجيين الذين احتجوا على الوحدة، وقال إن الواجب إنشاء «دولة اتحاد» لأنه كان يتطلع إلى ثورة عالمية.
هل لك أن تعرّف اصطلاح «دولة اتحاد» بشكل أوضح؟
رسمياً، تبنّى الاتحاد السوفييتي المساواة بين الجمهوريات، من روسيا الكبيرة إلى إستونيا الصغيرة. السبب وراء لعبة الاستقلال هذه هذه هو إعلان هذه الجمهوريات استقلالها أو نضالها لتحقيقه، ولكن البلاشفة نجحوا في السيطرة من خلال تقبّل بعض التطلعات القومية والثقافية، بما في ذلك منح الجمهوريات الحق في استخدام لغاتها.
كيف تغيرت العلاقة الروسية الأوكرانية بعد وفاة لينين واستلام ستالين السلطة؟
لم تتغير فور وفاة لينين لأن ستالين استمر في تنفيذ سياسات لينين أول الأمر، حيث أطلق حملة من أجل تقبل الأوكرانيين وغيرهم، وتقبل لغاتهم وثقافاتهم، فكان الجورجيون ينطقون بالجورجية والأرمن يتحدثون الأرمنية، ولكن الفكرة كانت تقبّلهم ما داموا يؤمنون بالفكرة الشيوعية وينتمون إلى المشروع الشيوعي.
وبعد ذلك، في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، بدأ ستالين بتغيير سياسته. يمكن تتبّع الإحياء التدريجي لأهمية اللغة الروسية والثقافة الروسية، التي كانت تُعتَبَر قبل تلك المرحلة إمبريالية ورجعية. ولكن، حتى في ذلك الحين، لم يشجّع الروس اللغات الأخرى ولكنهم لم يهاجموها في الوقت نفسه، وذلك حتى المجاعة في أوكرانيا بين عام 1932 وعام 1933. هذه المجاعة مثّلت نقطة تحوُّل من جوانب متعدّدة، لأن الروس عندها لم يستهدفوا الحبوب فقط بل استهدفوا اللغة الأوكرانية أيضاً.
في مرسوم صدر عام 1932، أوقف ستالين دعم تعليم اللغة الأوكرانية في أماكن إقامة الأوكرانيين خارج أوكرانيا، سواء كانوا في روسيا أم في جمهوريات أخرى. بذلك، منع الروس التعليم أو النشر باللغة الأوكرانية خارج جمهورية أوكرانيا السوفييتية الاشتراكية. ونفّذت روسيا سياسات فرضت سيطرة أشد على الأنشطة الثقافية الأوكرانية داخل أوكرانيا، وذلك لمواجهة احتمال نشوء نزعة قومية أوكرانية. بعدها، استهدف الروس أبرز شخصيات الحزب الشيوعي الأوكراني والمؤسسة الثقافية الأوكرانية، حتى انتهى الأمر باثنين من هذه الشخصيات، على الأقل، بالانتحار عام 1933. لم تكن مجاعة فحسب، بل ظاهرة أوسع. وقد قال رافائيل ليمكين، الذي وضع مفهوم الإبادة الجماعية، إن الإبادة الجماعية في أوكرانيا لم تحدث بالمجاعة وحدها بل بالهجوم الأوسع على المؤسسات واللغة والثقافة في أوكرانيا.
أود الانتقال إلى تفكك الاتحاد السوفييتي بعد ستين عاماً واستقلال أوكرانيا. كيف تنظر إلى ما جرى عام 1991 وتلك السنوات الأولى من استقلال أوكرانيا؟
كان هناك اختلاف هائل بين تلك الفترة والفترة بين 1917 و1918. في الفترة الأولى، ارتبطت فكرة قيام دولة أوكرانية أو اندلاع ثورة أوكرانية بالبعد القومي، رغم وجود العديد من الأقليات على الأراضي الأوكرانية، ومنها الروس والبولنديون، الذين نظر كثير منهم إلى فكرة استقلال أوكرانيا بعين القلق والشك. ولكن، بحلول عام 1991، تغيرت فكرة الأمة الأوكرانية وصلتها باللغة والثقافة، وأصبح قيام الدولة الأوكرانية في المخيلة العامة عملية إقامة دولة مدنية ناشئة. في ذلك الوقت، كان سكان المدن الصناعية الكبيرة يتحدثون الروسية، ورغم ذلك بلغت نسبة المؤيدين للاستقلال أكثر من 90 في المئة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 1991. كان للقومية واللغة أهمية، ولكنها أهمية ثانوية، وعبّرت أغلبية السكان في المناطق الأوكرانية كافة عن تأييدها للاستقلال.
كيف تتجلى الانقسامات اللغوية بين السكان، عدا عن الانقسام بين الغرب والشرق؟
تاريخياً، كانت اللغة الأوكرانية هي لغة الأرياف. شهدت البلاد، خلال القرن العشرين، عملية تحديث وتمدين، ودمج الفلّاحين وسكّان الأرياف السابقين في الثقافة المدينية من خلال اللغة الروسية. أدى ذلك إلى نشوء مجموعة كبيرة من الناس يرون في اللغة الأوكرانية لغتهم الأم وينتمون إلى الهوية الأوكرانية رغم أنهم كانوا ينطقون بالروسية.
يُخيّل إلي أن هذا قد تغير إلى حد ما، أعني اللغة التي يتحدث بها الناس في المدن الكبيرة.
وقع هذا التغير خلال السنوات الثماني الماضية. لعل بعض التحركات بهذا الاتجاه وُجِدت قبل ذلك، ولكن تبني اللغة الأوكرانية كان، في الواقع، رد فعل على الحرب التي اندلعت عام 2014. كانت ذريعة روسيا حماية السكان من القمع الثقافي وغيره من أشكال القمع. نتيجة ذلك، اتّخذ الشباب، ولا سيما طلبة الجامعات، في المدن الكبيرة قراراً واعياً بالتحدث بالأوكرانية. لم يكن ذلك صعباً على الذين تعلّموا اللغتين في طفولتهم، فازداد عدد من يستخدمون اللغتين، أو يفضّلون اللغة الأوكرانية ويرسلون أطفالهم إلى مدارس تُدرِّس باللغة الأوكرانية.
هل لخطاب بوتين هذا الأسبوع علاقة بالمحادثة التي نخوضها؟
ما نراه في خطاب بوتين هو رفض سياسات الحقبة السوفييتية، فقد حمّل الاتحاد السوفييتي المسؤولية عن كل شيء، حتى إنشاء أوكرانيا. ما نراه اليوم هو عودة إلى فهم الهوية الروسية كما كان قبل الثورة البلشفية، وهي فكرة إمبريالية للغاية عن الأمة الروسية، التي تضم الروس والأوكرانيين والبيلاروسيين. يكاد الحال اليوم يكون كما كان عليه في منتصف القرن التاسع عشر، حين حاول مسؤولو الإمبراطورية الروسية تعطيل نمو وتطور الثقافة والأفكار الأوكرانية.
هل هذه الفكرة حول روسيا التي تشبه الإمبراطورية، والتي لا تسمح بوجود هوية أوكرانية إلا داخلها، تجذب عدداً كبيراً من الأوكرانيين وإن لم يكونوا الأغلبية؟
لاقت هذه الفكرة رواجاً، بالتأكيد، في القرم عام 2014، حيث كان معظم سكان المنطقة من أصل روسي، وهؤلاء رفضوا فكرة الهوية الإقصائية، الأمر الذي مهّد الطريق لمقولة: نعم، لعلنا أوكرانيون، ولكن المجال يتّسع لدور أكبر لروسيا.
هل ترى أن هناك بعض الشوفينية داخل روسيا، حتى بين مَن لا يؤيدون بوتين، إزاء المسألة الأوكرانية؟ أم تستشعر انقساماً أكبر في روسيا؟
كان كثيرون يشعرون بأن القرم تنتمي إلى روسيا، حيث كانت نسبة تأييد بوتين مرتفعة بعد ذلك. أما فيما يتعلق ببقية الأراضي الأوكرانية، فثمة بعض الغموض، حيث ازدادت المسافة بين روسيا وأوكرانيا في نظرة كل شعب إلى الآخر منذ اندلاع الحرب. لستُ عالم اجتماع، ولكني أشعر بأن تبنّي السردية الروسية لتاريخ أوكرانيا في تراجع. بدأ التاريخ الروسي في كييف، وهذا ما يتعلمه الأطفال في المدارس، وهذا مؤثر، ولكن الواقع يزيد من التشكيك في السردية التاريخية.
يبدو أنك ترى بأن بوتين، بشنّه هذه الحرب على أوكرانيا، قلّل من الشعور الشعبي الروسي بأنّ الجانبين دولة واحدة.
نعم، هذا هو انطباعي، ولقد ساهم الخطاب الروسي المقاوم للهوية الأوكرانية في ذلك. إذا واصل بوتين الحديث عن الفاشيين وما شابه، فهذا لا يساهم في تعميم شعور بالوحدة بين الشعبين. وصفت البروباغاندا الروسية المتظاهرين في ساحة ميدان بأنهم قوميون متعصبون. عندما تُصوّر مواطني دولة أخرى بهذه الصورة، فإن ذلك لا يعزّز خطاب الأخوة والوحدة.
إذا أقدمت روسيا على غزو معظم الأراضي الأوكرانية أو كلها، ما حجم المقاومة الذي تتوقعه؟ هل تشعر بأنه سيصعب قمع هذه المقاومة حتى إذا هُزِم الجيش الأوكراني رسمياً؟
نعم، هذا هو شعوري. وقد يختلف الأمر من منطقة إلى أخرى. قد لا يصل بوتين أبداً إلى غرب أوكرانيا. أعتقد أنه سيلقى مقاومة شديدة في وسط أوكرانيا. لم تقتصر نتائج هذه الحرب على تعزيز الهوية الأوكرانية وازدياد الارتباط بالثقافة الأوكرانية، فهناك شرائح كبيرة من الشعب الأوكراني لم تعد ترى في حمل السلاح للدفاع عن وطنها فكرة راديكالية. وقد خضع الآلاف للتدريب العسكري، ولسوف يقاتلون. لا أعلم متى وكيف، ولكن لا ريب عندي أن الروس سيواجهون مقاومة أوكرانية.
ما رأيك في تعامل الرئيس زيلينسكي مع ما يجري؟ تَحَوُّله من محاولة تهدئة المخاوف والذعر إلى السفر إلى ألمانيا للحديث عن الترضية لافت للنظر.
امتدت حالة الإنكار لفترة طويلة جداً. لا أعرف الأسس التي استند إليها في إنكاره ذلك، ولكنه كان منسجماً مع المجتمع الأوكراني الذي لم يكن يريد هذه الحرب، ولم يكن مستعداً لها، وبالتالي لم يرد التفكير فيها. وساد اعتقاد في أوكرانيا بأن بوتين لن يجرؤ على فعل شيء لأن العالم يراقبه عن كثب. ولكن هذا تغير في الأسبوعَين الماضيَين وأدرك الأوكرانيون أن الغزو حقيقة، وهذا هو سبب التغير في سلوك القيادة.
موقع الجمهورية
—————————
واشنطن تحشد حلفاءها في الملف السوري لـ«أسباب أوكرانية»
تستضيف اجتماعاً لمبعوثي دول أوروبية وعربية وتركيا غداً
لندن: إبراهيم حميدي
مضت واشنطن في خطتها لاستضافة مبعوثي الدول الحليفة في الملف السوري غداً؛ ما سيشكل فرصة لاختبار «الحلفاء» مدى انعكاس الحرب الأوكرانية والتصعيد العسكري الروسي – الغربي هناك، على «المسرح السوري».
ومن المقرر أن يستضيف مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية إيثان غولدريش مبعوثي عدد من الدول الأوروبية والعربية والاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع تنسيقي في واشنطن غداً (الخميس)، يبدأ بتقديم المبعوث الأممي غير بيدرسن إيجازاً سياسياً، على أن يقوم المبعوثون لاحقاً بعقد جلسة تشاورية لـ«ضبط الإيقاع» وبحث الوضع الميداني في سوريا ومواقف الدول العربية «التطبيعية» وتأثيرات الحرب الأوكرانية على كل ذلك.
غزل مع تركيا
وكان لافتاً، أن واشنطن حرصت على دعوة أنقرة إلى الاجتماع في ثاني خطوة من نوعها، بعد حضور ممثل تركيا في الاجتماع السابق الذي جرى في بروكسل بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار مساعٍ أميركية لـ«جلب أنقرة من التطابق مع الموقف الروسي، وتخفيف حدة التوتر بسبب دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية الكردية – العربية شرق سوريا، وانخراط أنقرة مع موسكو وطهران في مسار آستانة».
وحسب المعلومات، فإن بيدرسن سيقدم عرضاً سياسياً للأوضاع السورية، وسيؤكد نيته المضي قدماً في رعاية اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، بدءاً من 21 الشهر الحالي، بمشاركة وفدي الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة والمجتمع المدني.
وكان بيدرسن وجّه إلى رؤساء الوفود دعوات رسمية تعرض تصوراً خطياً للجولات المقبلة من عملة اللجنة الدستورية، وتطلب من وفدي الحكومة والمعارضة تقديم اقتراح خطي لكل مبدأ من مبادئ الدستوري قبل أيام من المغادرة إلى جنيف، والاستعداد للانتقال إلى صياغات تقريبية بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ثلاثية تضم بيدرسن ورئيسي «الوفد المدعوم من الحكومة» أحمد الكزبري، ووفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة.
كما يُتوقع أن يقدم بيدرسن خلاصة اتصالاته مع دمشق والمعارضة والدول المعنية، في شأن اقتراحه بدء العمل على مقاربة «خطوة – خطوة» التي تضمن إقدام الأطراف على إجراءات بناء ثقة متبادلة تخص وقف النار وتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية والعقوبات، ووصولاً لتنفيذ القرار 2254.
وكان الاقتراح يعتمد أساساً على إمكانية حصول تفاهمات أميركية – روسية، والانطلاق من اتفاق الطرفين على تمديد قرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود للوصول إلى توفير أرضية لتحريك مبادرة «خطوة – خطوة». وبعد الحرب الأوكرانية والانقسام الغربي – الروسي، طُرحت أسئلة حول مدى واقعية المضي قدماً في «خطوة – خطوة» حالياً.
ثلاثة أسئلة
وفي القسم الثاني من اجتماع الخميس، يتناول المبعوثون التطورات السورية الأخرى، بينها الوضع الإنساني والعسكري والاقتصادي. وحسب مسؤول غربي، فإن الحرب الأوكرانية أظهرت مدى اعتماد روسيا عسكرياً على قاعدة حميميم في استراتيجيتها بالعالم؛ ما يطرح الأسئلة: «في حال تحولت حرب أوكرانيا إلى استنزاف، هل تستطيع روسيا الاستمرار في انخراطها ذاته في سوريا؟ ما مستقبل التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في سوريا؟ ما مستقبل اتفاق منع الصدام بين روسيا وأميركا شرقي سوريا؟».
وتظهر المؤشرات الأولية، أن موسكو وتل أبيب ملتزمتان اتفاق «خفض التصعيد» خلال قيام إسرائيل بشن غارات على مواقع إيرانية في سوريا، وأن التصعيد الروسي – الغربي في أوكرانيا لم ينعكس توتراً ميدانياً شرقي سوريا إلى الآن، حسب المسؤول، الذي يطرح المزيد من الأسئلة: «هل نشهد في المرحلة المقبلة قيام إيران بملء الفراغ العسكري الذي يمكن أن تتركه روسيا في سوريا؟ هل يمكن أن تقوم طهران بتقديم مساعدات اقتصادية إضافية إلى سوريا بسبب انشغال روسيا وإمكانية المكاسب الاقتصادية في حال توقيع الاتفاق النووي بين طهران والغرب؟ هل هذا أحد أسباب زيارة مدير الأمن الوطني السوري اللواء على مملوك إلى طهران حالياً؟».
في هذا المجال، فاقمت حرب أوكرانيا الأزمة الاقتصادية السورية لتراجع واردات النفط والحبوب، في وقت تقترب مستويات الفقر في سوريا من 90 في المائة، ويعاني 12.4 مليون شخص، أي 60 في المائة من السكان، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة الآمنة أو الكافية في شمال سوريا.
تطبيع وعقوبات
وإلى هذه الأمور، يتوقع أن يتناول اللقاء بين المبعوثين ملف التطبيع العربي مع دمشق والعقوبات الغربية عليها.
وكان الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعاً على المستوى الوزاري الشهر الماضي، لبحث الملف السوري، انتهى إلى التأكيد على أن «المبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي لا تزال صالحة وقائمة، وهي: لا تطبيع، ولا رفع للعقوبات، ولا إعادة بناء، إلى أن يشارك النظام في انتقال سياسي داخل البلاد في إطار قرار مجلس الأمن 2254». ويُظهر أنه سيكون واقعياً وينخرط باقتراح بـ«خطوة – خطوة» ومضمون القرار الأممي لدعم «التعافي المبكر» في مشاريع المساعدات الإنسانية، تحت سقف الخطوط الحمراء» و«اللاءات الثلاثة» الأوروبية.
وأبلغت واشنطن دولاً عربية في الأقنية الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة الدول العربية، مع إشارتها إلى أن خلاصة المراجعة السياسية داخل مؤسسات الإدارة الأميركية أسفرت عن الوصول إلى تحديد أولويات الإدارة في سوريا، وهي: المساعدات الإنسانية مع التركيز على التعافي المبكر، الحفاظ على الوجود العسكري شرق الفرات لمحاربة «داعش»، دعم وقف إطلاق النار، الالتزام بالمساءلة عن جرائم الحرب والملف الكيميائي، واختبار إمكانات تحريك العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254.
ولا خلاف على أن الحرب الأوكرانية، مناسبة لاختبار هذه المواقف ومدى التمسك فيها، وسط وجود رأيين: الأول، يقول بضرورة «الفصل بين الملفات» وعدم تداخلها، بحيث تفصل واشنطن مفاوضات الملف النووي الإيراني والوجود العسكري في سوريا عن التصعيد شرق أوروبا، وبين دعوات للتشابك بين الملفات وعدم إمكانية العزل بينها إذا طال أمد الحرب وتلمس إمكانية تبادل توجيه الضربات في سوريا لـ«أسباب أوكرانية».
الشرق الأوسط
—————————–

تأملات عسكرية في حروب العراق وسوريا وأوكرانيا/ جلبير الأشقر
قبل يوم من قرار فلاديمير بوتين غزو كامل الأراضي الأوكرانية، نشرت مجلة «ذي أتلانتيك» الأمريكية مقابلة أجرتها مع الجنرال ديفيد بتريوس، الذي قاد إحدى فرق جيش الولايات المتحدة في غزوه للعراق في عام 2003، وكان آنذاك جنرالاً بنجمتين (لواء) ثم تولّى مسؤوليات متعاظمة وصولاً إلى قيادة كافة قوات الاحتلال في مرحلة «الطفرة» التي شهدت زيادة مؤقتة في عدد الجنود الأمريكيين بدءاً من عام 2007، وكان قد حصل بتريوس عندها على نجمته الرابعة. ثم غادر العراق في عام 2008 لتولّي مسؤوليات عسكرية أخرى، كانت آخرها قيادة القوات الأمريكية والحليفة في أفغانستان لمدة سنة قبل تقاعده من القوات المسلّحة في صيف عام 2011.
فبتريوس إذاً مخضرمٌ في إدارة الاحتلالات وكان خيار المجلة بإجراء مقابلة معه في شأن احتمال الاحتلال الروسي لأوكرانيا خياراً حكيماً بالتأكيد. سأله الصحافي الذي أجرى المقابلة: «حشدت روسيا قوات عسكرية حول أوكرانيا يبدو أن تعدادها 190.000. هذا لا يزيد كثيراً عن عدد قوات التحالف خلال الطفرة في العراق. لكنّ أوكرانيا بلد أكبر وشعبه أكثر عدداً. هل تستطيع روسيا السيطرة على كافة أراضي أوكرانيا؟»
طبعاً، للبلدين اليوم، العراق وأوكرانيا (بدون شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا) حجمٌ سكاني متساو تقريباً يناهز 40 مليوناً، لكنّ تعداد سكان العراق عند بدء الاجتياح قبل عشرين عاماً كان أقل بكثير من العدد الحالي، يزيد قليلاً عن 25 مليوناً. أما مساحة أوكرانيا فهي أيضاٌ تزيد عن مساحة العراق بنسبة النصف تقريباً. وتنضاف إلى هذه المعطيات جملة أمور تعقّد الحالة الأوكرانية بالمقارنة مع الحالة العراقية: منها أن نسبة سكان العراق الذين لم يكونوا مؤيدين للنظام ولا معادين للاحتلال أعلى بكثير من نسبة سكان أوكرانيا الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، في ضوء ما كشفت عنه الحرب الدائرة حتى الآن؛ ومنها أن القوات المسلّحة الأوكرانية أقوى بكثير مما كانت عليه القوات العراقية إثر تدميرها في عام 1991 وبعد اثنتي عشرة سنة من حظر مطبق للأسلحة وقطع الغيار.
كل هذه الأمور تؤكد أن فلاديمير بوتين ارتكب خطأ جسيماً في الحساب أخطر بعد من خطأ إدارة جورج دبليو بوش التي أقنعت نفسها (وأقنعها من أرادت الاستماع إليه من العراقيين، وأولهم أحمد الجلبي) بأن الشعب العراقي سوف يستقبل قواتها بالورود. هذا ما حدا بوزير الدفاع الأمريكي آنذاك، دونالد رامسفلد، على الإصرار على اجتياح العراق بقوات لم يبلغ عددها سوى 125,000 بالرغم من تحذير جنرالات البنتاغون له بأن هذا العدد لن يكفي للسيطرة على العراق. وهذا ما عناه بتريوس في ردّه على الصحافي قائلاً:
«بصراحة، وصولنا إلى بغداد، بالرغم من أنه كان أصعب مما تصوّره الكثيرون عن بُعد، كان يسيراً إلى حد بعيد. لكن لمّا انهار النظام، لم تكن لدينا قوات كافية ولو بحد أدنى لمنع السرقات، ولم تكن لدينا لاحقاً قوات كافية للتصدّي للجماعات المسلّحة والمتطرّفة عندما زادت حدة العنف بصورة دراماتيكية في عام 2006 إلى أن وصلتنا قوات إضافية خلال الطفرة التي دامت 18 شهراً»…
ثم أضاف بتريوس في صدد الحديث عن قوات الطفرة المساوية للقوات الروسية التي جرى حشدها على تخوم أوكرانيا: «عددٌ من القوات يبلغ 190,000 يبدو كأنه كبير، لكنّ عمليات مكافحة التمرّد تستهلك الكثير من الجنود. فإذا نظرنا في الأفراد المنتشرين فعلاً على أرض المعركة والذين هم على استعداد لخوض عمليات مكافحة تمرّد تجري 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، فإن العدد الفعلي يصبح أقل إثارة للرهبة بكثير ويصبح عدد القوات المنتشرة قليلاً جداً في أماكن انتشارها».
بقي فارق آخر وهو الأهم: لم يكن لصدّام حسين، لا في عام 1991 ولا في عام 2003، أي سند عسكري خارجي، فخاض الحربين بعزلة تامة بلا امدادات بالسلاح والعتاد. أما في حالة أوكرانيا، فقد تعهّدت دول حلف الناتو تزويد المقاومة الأوكرانية بكافة أنواع الدعم باستثناء التدخّل المباشر في القتال. حتى أن الاجتياح الروسي قد أدّى إلى جعل أغنى الدول الأوروبية وأكثرها تقدماً في المجال الصناعي، وهي ألمانيا بالطبع، تنفكّ عن القاعدة التي التزمتها منذ نشأة دولتها الجديدة على أنقاض الحكم النازي إثر الحرب العالمية الثانية، وهي قاعدة عدم تسليم أسلحة نارية إلى قوى محاربة.
التزاماً بهذه القاعدة، فإن الحاجة العسكرية الوحيدة التي كانت ألمانيا قد سلّمتها لأوكرانيا حتى الآن تمثّلت بشحنة من الخوذات، ما جعل بعض المعلّقين يسخرون سائلين برلين إن كانت تنوي تسليم أوكرانيا مخدّات في الدفعة القادمة! وها أن برلين قرّرت تزويد الأوكرانيين بالسلاح، بل بنوعي السلاح اللذين هم بأمسّ الحاجة إليهما في تصدّيهم للاجتياح الروسي، وهما النوعان اللذان تحتاج إليهما أي قوات شعبية في تصدّيها لجيش متفوّق عليها بالطيران والآليات: صواريخ محمولة على الكتف، منها ألف صاروخ حديث مضاد للمدرّعات وخمسمئة صاروخ مضاد للطيران من نوع ستينغر.
ويجدر بالذكر في هذا الصدد أن واشنطن فرضت حظراً على تسليم هذين الصنفين من السلاح لقوات المعارضة السورية. كان هذا بالرغم من أن تركيا، سند المعارضة السورية الرئيسي، هي ذاتها صانعة لصواريخ ستينغر تحت وكالة أمريكية، وقد واجهت من قِبَل واشنطن تحريماً صارماً لتسليمها، نزولاً عند رغبة الدولة الصهيونية التي اعترضت اعتراضاً شديداً على ذلك حيث رأت أن من شأنه أن يشكّل تهديداً لطيرانها.
ولو تسلّمت المعارضة السورية صواريخ أرض-جو منذ البدء لاستطاعت أن تحرم قوات النظام من احتكاره للأجواء، بما كان يمكن أن يغيّر مصير الحرب السورية بالكامل. وفي الحقيقة، لو أبدت واشنطن استعداداً لتسليم صواريخ مضادة للطيران للمعارضة السورية، لشكّل ذلك رادعاً قوياً أمام تدخل سلاح الجوّ الروسي في الحرب السورية بدءاً من خريف 2015.
يشير ما سبق إلى الفارق العظيم الذي يشكّله العامل الإسرائيلي بين سوريا من جهة، وأفغانستان وأوكرانيا من الجهة الأخرى، إذ سلّم الغرب صواريخ ستينغر للمجاهدين الأفغان في قتالهم ضد الاحتلال السوفييتي وهو يستعد لتسليمها للقوات الأوكرانية في قتالها ضد الاحتلال الروسي، بينما احترم الفيتو الصهيوني بعدم تسليمها للمعارضة السورية.
كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
——————————-
بكين – موسكو .. زواج مصلحة/ علي العبدالله
لم يكن البيان الصيني الروسي الذي صدر عقب قمة الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والروسي، فلاديمير بوتين، في بكين يوم 4 الشهر الماضي (فبراير/ شباط) بياناً عادياً، بل كان “ثورياً” بما انطوى عليه من مواقف ومطالب تطيح النظام الدولي القائم، بقواعده القانونية وقيمه الليبرالية، وتؤسس لبديل متعدّد الأقطاب، يحتل فيه النظامان السلطويان موقعين ونفوذين كبيرين، ويشركهما في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، فالبيان، الذي جاء في 5300 كلمة، رفع البطاقة الحمراء في وجه الولايات المتحدة والنظام أحادي القطبية الذي تقوده، وحدّد الملفات التي عليها تغيير مقاربتها لها: تايوان والمطالب الأمنية الروسية، فلا تحالفات أمنية جديدة ولا توسيع لعضوية حلف الناتو. واعتبار ذلك قرينة صريحة على قبولها تغيير قواعد النظام الدولي، والانخراط في مفاوضات لصياغة البديل أو الانخراط في مواجهة صفرية.
لقد حدّد البيان حجم (ومستوى) الاتفاق على التعاون بين الدولتين، من التعاون الأمني إلى الفضاء والإنترنت والتغيرات المناخية مروراً بالذكاء الاصطناعي، فـ “لا حدود للصداقة”، و”لا توجد مجالات ممنوعة على التعاون”، وفق البيان، فالاتفاق الجديد الذي تجاوز معاهدة الصداقة بين الدولتين الموقّعة عام 2001، شراكة استراتيجية “غير مسبوقة”، وفق الرئيس الروسي، و”سيترك آثاراً بعيدة المدى على الصين وروسيا والعالم”، وفق الرئيس الصيني. وقد تضمّن البيان دعماً مباشراً للرئيس الروسي في مواجهته المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن أوكرانيا، وتعهداً بالوقوف إلى جانبه في مطالبه الأمنية، والتزاماً بدعمه إذا نفّذ الغزو، ومساعدته على تحمّل العقوبات الاقتصادية القاسية التي تخطّط الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرضها. وهو ما أكّده وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، بالمطالبة بمعالجة مظاهر القلق الروسي بشأن تمدّد “الناتو”، واصفاً إياها بالمشروعة؛ مع دعم روسيا لسياسة الصين الموحدة، التي ترى أنّ تايوان جزء من الصين ومعارضة أيّ شكل من الاستقلال.
شهدت العلاقات الروسية الصينية، العسكرية والاقتصادية، نمواً كبيراً في العقدين الأخيرين، على خلفية الرد على الموقف الأميركي، الذي وضعهما في وثائق أمنه القومي في خانة الأعداء المهددين للأمن القومي الأميركي، وتدخله في شؤونهما الداخلية، عبر ترويج القيم الليبرالية ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، وتهديده طموحاتهما عبر العمل على تقييد تحركاتهما السياسية والعسكرية، والحدّ من نفوذهما الإقليمي والدولي، بنشر موارد عسكرية ضخمة في المحيطين، الهندي والهادئ، اعتراضاً على مطالب الصين في بحري الصين، الجنوبي والشرقي، وتشكيل تكتلات أمنية وسياسية في الإقليم، تحالف “أوكوس” مع المملكة المتحدة وأستراليا والحوار الأمني الرباعي “كواد” مع اليابان والهند وأستراليا، وطرح مشروع غربي، مبادرة “إعادة بناء عالم أفضل” التي أطلقتها مجموعة الدول السبع، بديلاً لمبادرة الحزام والطريق، تقديم مساعدات للدول الفقيرة والنامية، لتطوير بنيتها التحتية والخدمية والاقتصادية، بالنسبة للصين، وإدماج أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بطريقةٍ عملية عبر إشراك قواتها في التدريبات والمناورات العسكرية، ومدّها بالأسلحة المتطورة ودعمها اقتصادياً، بالنسبة لروسيا، وقد تعدّدت التدريبات العسكرية الروسية الصينية في البحر والبر، والقيام بدوريات مشتركة وإجراء مناورات بحرية في المحيطين، الهندي والهادئ، بمشاركة آلاف الجنود وعلى مساحة واسعة.
وكان معهد البحرية الأميركي قد أشار، في تقرير له العام الماضي، إلى تتابع المناورات العسكرية بين قوات الدولتين وتعقيدها ومداها الجغرافي المتزايد بشكل مستمر، واعتبر امتداد أراضيهما في آسيا وأوروبا مع امتلاكهما أسلحة نووية يجعل تحالفهما بمثابة تغيير لقواعد اللعبة عسكرياً ودبلوماسياً، كما بيعت أسلحة روسية متطورة للصين. وهذا إلى جانب تنامي التبادلات التجارية وتوقيع عقود طويلة الأمد بمليارات الدولارات في مجال الطاقة لاستيراد كميات كبيرة من النفط والغاز الروسيين، ومد أنابيب لنقلهما مباشرة إلى الأراضي الصينية.
وقد ترتّب على التوترات والمواجهات السياسية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة حول ملفات جيوسياسية وجيوستراتيجية توافق روسي صيني على خطورة النظام الدولي القائم بأسسه الغربية، وسيطرة الولايات المتحدة على قواعد عمله وآلياته التنفيذية وتوافقا على ضرورة مواجهته وتغيير أسسه وقواعد عمله، وإقامة نظام دولي بديل متعدّد الأقطاب.
اعتبرت قراءات غربية البيان الصيني الروسي تحدّياً سياسياً وعسكرياً للنظام الدولي القائم؛ وخطّة واسعة لمواجهة الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كحجر أساس للأمن الدولي والليبرالية الديمقراطية؛ فـ “لا يوجد مقاس يناسب الجميع”، و”موسكو وبكين هما أنجح الديمقراطيات”، بحسب البيان، وتعهدا بالوقوف في صفٍّ واحد في مواجهة القواعد والقيم الغربية. واعتبرته، القراءات، في فحواه وتوقيته، عهداً جديداً في النظام الدولي، يضع الولايات المتحدة وحلفاءها أمام منعطف رهيب؛ ونقطة تحوّل جديدة في حربٍ باردةٍ جديدة.
غير أنّ قراءةً للعلاقات الصينية الروسية خارج اللحظة السياسية الراهنة ومستدعياتها، إن على صعيد التحرّك الأميركي لاحتواء الصين وحماية تايوان من اجتياح صيني محتمل، أو على صعيد تمدّد حلف الناتو نحو الحدود الغربية لروسيا، عبر ضم مزيد من دول شرق أوروبا للحلف، خصوصاً أوكرانيا وجورجيا، ونشر عتاد عسكري متطوّر في هذه الدول، والتي، وحدت اللحظة السياسية الراهنة موقفهما وعداءهما المشترك للولايات المتحدة، وفرضت عليهما تبادل التأييد والدعم في هذين الملفين الساخنين، تقود، القراءة، إلى وجود تباين في الرؤية وتعارض في المصالح، إذ تنطلق الصين من ضرورة الحفاظ على الاستقرارين، الإقليمي والدولي، لما لذلك من تأثير على مشروعها “الحزام والطريق” ومصالحها التجارية مع دول وسط آسيا وأوروبا، وتعارض التدخلات الخارجية في شؤون الدول، ما يجعلها ترى في تكتيكات الرئيس الروسي وعسكرته الدبلوماسية وتصعيده التوترات الإقليمية والدولية مسّاً بالاستقرار، وبالمصالح الصينية بالتالي، وخرقاً لمبدئها في معارضة التدخلات الخارجية.
صحيحٌ أنّ الصين تستفيد، في ظل التوتر القائم مع الولايات المتحدة بشأن الأدوار والأوزان، وواجهته ملف تايوان، من التحرّكات العسكرية الروسية لمشاغلة الولايات المتحدة وحرف الاهتمام الأميركي عن الاتجاه نحو آسيا وتطويقها وعرقلة خططها الجيوسياسية والجيوستراتيجية، وترى في بوتين شريكاً قادراً على زعزعة استقرار التحالف الغربي، ودفع الولايات المتحدة إلى وقف التركيز على احتوائها، إلّا أنّها لا تريد دفع الأوضاع مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو قطيعةٍ شاملةٍ وحرق كلّ المراكب معهما، وخسارة التبادلات التجارية الضخمة، خصوصاً إذا ترافقت القطيعة مع عقوباتٍ لها تأثير كبير على الشركات الصينية، فأولويتها مطلقة النفاذ إلى الأسواق، لذا لا تريد لدعمها روسيا أن يلحق ضرراً بمصالحها الخاصة، فمصالحها مع استقرار سياسي وأمني إقليمي ودولي. وهذا ما دفعها إلى اعتماد سياسة النأي بالنفس والحياد، وتفضيلها حلّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية، وتأكيد وزير خارجيتها، الذي انتقد تمدّد “الناتو” نحو حدود روسيا الغربية، على احترام سيادة أوكرانيا وحماية هذه السيادة، وقوله، في مكالمات هاتفية مع دبلوماسيين غربيين، إنّ “الصين تتابع تطور الأزمة الأوكرانية، والوضع الحالي أمرٌ لا تريد الصين رؤيته”. وحثّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي وقّع قبل أيام على البيان الصيني الروسي الذي ينطوي على دعم لموسكو، الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، في مكالمة هاتفية معه على حلّ الأزمة مع أوكرانيا من خلال المحادثات، ودعوة سفيرها لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية، وإيقاف مصرفين صينيين، البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين، تمتلكهما الدولة، إصدار اعتمادات مالية بالدولار الأميركي لشراء سلع روسية جاهزة للتصدير، خير دليل على طبيعة توجهاتها السلمية، فحروب بوتين المحتملة تؤثر مباشرةً على وصول النفط والغاز من آسيا الوسطى إليها عبر الأنابيب؛ وتعرقل سلاسل التوريد وانتقال السلع. فالصين لا تشجع الأسلوب العدائي الذي تتبعه روسيا في الملف الأوكراني، ولا تؤيد أيّ عدوان أو تدخل من أيّ دولة في شؤون دولة أخرى، سبق ووقفت خلف انسحاب القوات الروسية من كازاخستان، فقد جرى الانسحاب، بعد طلب وزير خارجية الصين ذلك مباشرة من وزير خارجية روسيا، فـ “بوتين يمثل صداعاً كبيراً لبكين” وفق للزميل الأول لدراسات الصين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، كارل مينزنر. وهذا بالإضافة إلى رغبة الصين “في النهاية في علاقات جيدة مع الولايات المتحدة” وفق قول وانغ هوياو، رئيس “مركز الصين والعولمة”، وهو مركز أبحاث مقرّه بكين، ويقدّم المشورة للحكومة. وقد تأكد ذلك في تمييزها موقفها عن الموقف الروسي بامتناعها عن التصويت في جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الأزمة الأوكرانية على مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، حين استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو).
في وقتٍ تسعى الولايات المتحدة لفصل روسيا عن الصين، تتعامل الأخيرة مع الموقف بدعم مطالب روسيا الأمنية من أجل تشتيت القوة الأميركية، لكن من دون التزام صلب يلزمها بإرسال قوات لمساندة الغزو الروسي، فثمّة حدود لما يمكن، وما ترغب، الصين القيام به من أجل روسيا في ضوء عوامل رئيسية: التجارة والعلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فمن شأن دعم العدوان الروسي بشكل علني أن يهدّد اتفاقاً استثمارياً رئيسياً، تحاول بكين التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، والتعرّض لعقوبات أميركية ثانوية مدمرة، وتتعامل مع الغزو كاختبار لاكتشاف مستوى الرد الأميركي، واعتباره مقياساً لردّه المحتمل على معركتها الخاصة بشأن تايوان، وفرصة لإضعاف روسيا منافستها الجيوسياسية في وسط آسيا، والمحصلة النهائية للغزو وانعكاساتها على المعادلتين، الإقليمية والدولية.
العربي الجديد
——————————-

مفارقات الحرب الروسية الأوكرانية/ علي أنوزلا
كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن مفارقات كثيرة، وعرّت عن حقائق كانت مُوَارَاة ننساها تغاضياً، وليس جهلاً بها، لكنّ الحروب، كما يقال كشّافةٌ، تكشف أجمل ما في الإنسان، ولا تكتفي بتعرية أسوأ غرائزه، وإنّما تصنعها وتضاعفها، كما قال الشاعر العربي القديم زهير بن أبي سلمي:
وَمَا الْحَرْبُ إلّا مَا علمتمْ وَذُقتُم/ وَما هوَ عَنها بالْحَديثِ الْمُرَجَّمِ
مَتى تَبْعَثُوها تَبْعَثُوها ذَميمَةً/ وتَضْرَ إذا ضَرّيْتُمُوها فتَضْرَمِ
فَتَعْرُكُكُم عرْكَ الرّحى بثِفالها/ وَتَلْقَحْ كِشافًا ثُمّ تُنْتَجْ فَتُتْئِمِ
هي الحرب إذاً، أو الهيجاء، كما كان العرب يسمونها قديماً، تهيّج النيران وتهيّج المشاعر والغرائز، ووسط هذا التهييج برزت عدة مفارقات منذ الأيام الأولى لاندلاع هذه الحرب، وما قد تكشف عنه الأيام المقبلة سيكون أفظع وأعظم.
أولى هذه المفارقات أنانية الرجل الأبيض الغربي، والتي تجلت في هَبّة الدول الغربية، من أوروبا إلى أميركا لنصرة شعب أوكرانيا الأبيض الأوروبي المسيحي، وهذا موقفٌ يحسب لهذه الدول وشعوبها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بهجوم غاشم من قوة معتدية توسعية، يقودها رجل يعاني من جنون العظمة. رَدّة الفعل الغربية جاءت سريعة، عقوبات قاسية اقتصادية ومالية ورياضية غير مسبوقة في التاريخ ضد روسيا، ودعم سخي بالمال والسلاح تدفق بسرعة من دون تردد ومن دون حساب، ومن كلّ الدول الغربية بلا استثناء، وفتح الأبواب واسعة أمام المتطوعين من الدول الغربية للقتال في صفوف القوات الأوكرانية، وتضامن رسمي وشعبي جاء سريعاً وواسعاً أخرج دولاً عن حيادها التاريخي، مثل سويسرا والسويد، ودفع ألمانيا “غير المسلحة” إلى التكشير عن أنيابها، وذهب بحماسة وزيرة خارجية بريطانية، ليز تراس، إلى الإعلان عن تشجيع مواطني بلدها للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الهجوم الروسي!
حدث هذا التحرّك الغربي الجماعي والموحد، بل والمطلوب في مثل هذه الحالة، بدعوى أنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا ليس مقبولاً من وجهة نظر القانون الدولي، والسكوت عنه ليس مبرّراً لا سياسياً ولا أخلاقياً، وجاء أيضاً باسم الدفاع عن القيم الغربية، لكن للمفارقة أنّ هذه الدول لم تستحضر، بالأمس القريب، كلّ هذه المبادئ والقيم التي تدافع عنها اليوم عندما دمّرت قواتها الغازية دولاً كاملة، وقتلت من شعوب هذه الدول وهجّرت ملايين منها وأفقرتها في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال، والمبادئ والقيم نفسها تغيب عن “راداراتها” الأخلاقية كلّ يوم عندما يدوس عليها يومياً، وعلى مدى ستة عقود، جيش الاحتلال الصهيوني العنصري (ومستوطنوه) الذي يقتل الفلسطينيين الأبرياء ويهجّرهم ويعتقلهم، بعدما اغتصب أرضهم واحتل ديارهم. لقد فضحت هذه الحرب، بما لا يدع أيّ مجال للشك أو المزايدة، سياسة الكيل بمكيالين التي تتحكّم في أنانية العقل الغربي المسيحي، عندما يتعلق الأمر بادّعائه الدفاع عن الأخلاق والمبادئ والقيم.
المفارقة الثانية مرتبطة بمركزية الاهتمام بالإنسان الغربي، وكشفت عنها وسائل إعلام غربية كبيرة، لم تظهر فقط تحيّزها، وإنما أبانت أيضاً عن عنصريتها في تغطيتها الحرب، وتمييزها المقيت بين ضحايا هذه الحرب، وأغلبهم من المدنيين، من أوكرانيين وغربيين ومن جنسيات أخرى، لكنّ وسائل إعلام غربية أبانت عن تحيزها للضحايا الأوكرانيين والأوروبيين “المتحضّرين” مقابل ليس فقط تهميش الضحايا واللاجئين من جنسياتٍ أخرى في تغطياتها، وإنّما استعمال، وبطريقة مجّانية، صوراً نمطية تصفهم بالتخلف والهمجية والفقر، من دون مراعاة مشاعر ومعاناة آلاف من اللاجئين المشردين في جميع أنحاء العالم، ضحايا الحروب والمآسي التي صنعها الغرب في بلدانهم!
المفارقة الثالثة، وهذه أكثر قسوة، تلك التي نقلتها بعض مقاطع الفيديو وتظهر عناصر من الجيش الأوكراني ومن حرس الحدود البولندي يمنعون النازحين الأفارقة السود والعرب والهنود، الذين يميزهم لون بشرتهم، من عبور الحدود أو الصعود إلى الحافلات والقطارات، بينما يسمحون للأوكرانيين البيض! وحملت مقاطع الفيديو نفسها عبارات عنصرية حاطّة ومهينة، كان يتلفظ بها عناصر شرطة أوكرانيون وبولنديون في حق هؤلاء اللاجئين الهاربين من أوار الحرب، من جنسيات أفريقية وعربية وآسيوية. ففي زمن الحرب تطفو الفطرة الإنسانية في كلّ تجلياتها الجميلة والقبيحة، لكن تبرز أيضاً الغرائز البشرية المقيتة. وفي هذه الحالة، حضرت العنصرية البيضاء بكلّ بشاعتها ورعونتها، لتسيء إلى التضامن الشعبي الكبير والواسع عبر العالم مع الشعب الأوكراني، فليس أقسى وأمرّ من ظلم الضحية الضحية.
المفارقة الرابعة، تلك التي كشفت عنها مواقف عبر عنها مثقفون عرب ووسائل إعلام عربية وليس فقط مستخدمو مواقع التواصل ومنصّاته، من العرب، يساريين وإسلاميين، وأغلبها مساندة للغزو الروسي لأوكرانيا ومبدية إعجابها بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقط لأنّه يواجه الغرب، أو متشفية في الشعب الأوكراني، لأنّ جيشه شارك في التحالف الغربي الذي دمر العراق في تسعينيات القرن الماضي، أو ناقمة على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب ديانته اليهودية، أو لأنّه لا يخفي مساندته إسرائيل. وفي كلّ هذه الوقائع كثير من الصواب، لكن هذه المواقف تبدو، في هذه الحالة، خارج السياق، لأنّ لا شيء يبرّر الغزو والاعتداء، ولا عذر لمن سيختار الوقوف إلى جانب دكتاتور قاتل مثل الرئيس الروسي، يساند مجرماً مثل بشار الأسد، ويدعم انقلابياً مثل عبد الفتاح السيسي، ويرسل مرتزقة “فاغنر” لتقاتل في سورية وليبيا وتشاد ومالي، ويقتل معارضيه بكاتم الصوت أو بالسمّ الزعاف.
الخيار الذي اتخذه قيصر روسيا المعاصر، لتسوية نزاعه مع أوكرانيا بالقوة، يجب أن يرفضه جميع الديمقراطيين والأحرار في العالم، حتى لو كانت شعوبهم ضحايا الديمقراطيات الغربية المركزية والأنانية، فلا يمكن لقانون الغاب أن يحلّ محل القانون الدولي والأخلاق الإنسانية والقيم الكونية. الحرب هي، قبل كلّ شيء، معاناة وموت أبرياء وزرع بذور العداء بين الشعوب، وأولئك الذين يجدون الأعذار والمبرّرات لديكتاتورٍ مصاب بجنون العظمة، بدافع العداء البدائي والأعمى لأميركا أو بمثابة رد فعل معادٍ للغرب الاستعماري، فإنّ القيم والمبادئ واحدة لا تتجزأ وغير قابلة للانتقاء. ليس مطلوباً من المرء دائماً الاصطفاف الحرفي بانضباط وراء الطابور، وإنّما التماهي مع المبادئ التي يؤمن بها والقيم التي يدافع عنها، فهي بوصلته في حالة الحرب والسلم، حتى لا يسقط في ما سقط فيه الغربيون الأنانيون وإعلامهم العنصري من تناقضات صارخة أسقطت عنهم آخر أوراق التوت التي كانوا يتدثّرون بها.
العربي الجديد
————————-
أوكرانيا .. لزوم ما لا يلزم/ عبد اللطيف السعدون
“تبدأ الحرب في مكان ما، هنا أو هناك، غير أنها تمتد تماما مثل بقعة زيت على بساط من قماش الكتّان، وتتقدّم، تتقدّم أكثر حتى تقترب من مدينتك، من الحي الذي تقيم فيه، إلى أن تصل إلى باب منزلك، حينها سوف تصدّق أنها الحرب”، يمكن أن يكون رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، قد تذكّر هذه “الثيمة” التي أطلقها الأرجنتيني سيرجيو هارتمان على لسان بطل قصته اللافتة “يوم من ضمن أيام أخرى”، بعدما كان تجاهل دقات الطبول زمناً إلى أن حطّت الحرب عند باب منزله في “يوم أسود”، بوصف المستشار الألماني أولاف شولتز. عندها أدرك أن القيصر قد فعلها، ولذا قرّر أن يقاتل، ارتدى بزّة استعراضية لم يلبس مثلها سوى في السينما يوم كان ممثلا كوميدياً، جرّب أن يستنجد بحلفائه السبعة والعشرين زعيماً أوروبياً “من مستعدٌّ للقتال معنا؟”، لكنّ أيّاً منهم لم يردّ سوى بعبارات تعاطف ومواساة، والبيت الأبيض نفسه أكّد أن “بلادنا لن تدخل في حربٍ مع روسيا، ولن تذهب قواتنا لمواجهة عسكرية في أوكرانيا”، أسقط في يد زيلينسكي: “تركونا وحدنا ليشاهدوا الحرب على الشاشة”. في تلك اللحظة التاريخية الفارقة، اكتشف أنّ “البيت الأبيض” لن ينفع في اليوم الأسود، وألغى متابعة تغريدات الرؤساء على “تويتر” احتجاجاً!
صحيحٌ أنّ زيلينسكي كان يخاف روسيا، ولا يثق بها، ويدرك أنّها قادمة يوماً ما لابتلاع بلاده، لكنّه لم يكن ليتصوّر أنّ خطوتها هذه سوف تتم بهذه السرعة. وكان وضع في حسابه الانضمام، عاجلاً أو آجلاً، لحلف الناتو الذي سيتكفّل بحمايته، لكنّه يشعر اليوم بالخذلان، ويريد إعادة النظر في حساباته، لكنّ وقائع الأيام الأخيرة تعلمه أنّ الوقت قد فات.
في موسكو، على الجانب الآخر، كان القيصر يعرف جيداً أسرار اللعبة التي تمتلك جاذبيتها عليه، له خبرته العريضة فيها ابتداءً من المخابرات إلى السياسة إلى الرئاسة، عرف القانون والاقتصاد، وعرف أكثر لعبة الحرب. اختبرها في الشيشان وجورجيا، وبرع فيها عندما ضمّ شبه جزيرة القرم، وانطلق يؤسّس عملياً رهانه الاستراتيجي على إحياء دور روسيا في قيادة العالم، كما كان الاتحاد السوفييتي السابق. وقد رسم مساراً يتيح له تحقيق هدفه في الحصول على مدى جيوسياسي أوسع في أوروبا والعالم، ونجح في وضع أقدامه في “المياه الدافئة”، عبر تموضعه في سورية، ثم أمسك باللعبة في يده، طارحاً على الغرب شروطَه في طلب ضماناتٍ بمنع امتداد حلف الناتو شرقا، وعدم انضمام أوكرانيا، أو أيٍّ من الجمهوريات السابقة إلى الحلف، ومتوجّها، هذه المرّة، نحو كييف عاصمة أوكرانيا، منظّرا لما أسماها “تاريخية أوكرانيا الروسية”، ناظرا إليها أنها “دولة مصطنعة”، وأنّ ضرورات الأمن القومي لبلاده تفرض إلحاقها بروسيا أو على الأقل تنصيب حكومة موالية له فيها، وهو، في خطوته الماثلة، أعدّ كلّ الاشتراطات التي تخدمه، خصوصاً أنّ إمكانات أوكرانيا العسكرية لا يمكن أن تضاهي مثيلتها الروسية، وقد لا تصل إلى ثلث إمكاناتها، بعدما تخلت طواعيةً عن قدراتها النووية التي ربما شكلت، لو كانت باقية، عامل لجم لروسيا أو لغيرها، فضلاً عن قناعته المستجدّة بأنّ الغرب، وأميركا بالذات، لن يغامر في الدخول في مواجهةٍ عسكريةٍ مباشرة. ولعلّ هذه المعطيات تبلورت في ذهنه، حتى دفعته إلى الانخراط في مغامرته بدقة وتصميم، مظهراً عزمه على المضي بها إلى نهاية الشوط، ومتمثلاً مقولة الفيلسوف البريطاني، برتراند رسل: “إنّ أيّة حرب لا تحدّد من هو صاحب الحق فيها، لكنّها تحدّد الطرف الذي يبقى إلى النهاية”، وهو اليوم يرفع صوته عالياً إلى درجة تلويحه بتفعيل أسلحة الردع النووي ضد خصومه، فيما يبدو غريمه الرئيس الأوكراني مرتبكاً وغير قادر على تحديد أولوياته، خصوصاً بعدما صدمه الأميركيون والأوروبيون في عدم دخولهم الحرب، والاكتفاء بمدّه بحزمة مساعدات عسكرية، إلى جانب معاقبة روسيا اقتصادياً ومالياً، وقد قبل أن ينزل إلى حلبة التفاوض بأمل أن يجنب شعبه المزيد من إراقة الدم.
بقي أن نعرف أنّ كلّ هذه التداعيات تعكس في طياتها واحدةً من معضلات النظام الدولي الماثل الذي تبقى فيه القوة المعيار الأساس في حلّ المشكلات. وفي ظل هذا المعيار غير العادل، لا تملك الدول الصغيرة سوى خيار الإذعان لما يقرّره الأقوياء لها، مع التسليم باحتمال ظهور معطياتٍ غير محسوبة، قد ترغم المشاركين في اللعبة على لزوم ما لا يلزمهم.
العربي الجديد
—————————-
العرض في أوكرانيا والمواجهة في خليج تايوان/ عبدالناصر العايد
يمكننا قراءة قرار الرئيس الروسي بشن الحرب في أوكرانيا، من إحدى الزوايا، كمحاولة لاستغلال تركيز الولايات المتحدة وانشغالها بمقارعة الصعود الخطير للقدرات العسكرية الصينية من جهة، وضعف أوروبا عسكرياً وعدم رغبتها بالحرب من جهة ثانية. لكن يبدو أن الزعيم الروسي الذي يتقن المجازفات المحسوبة، لم يكن عقلانياً بما يكفي حين اتخذ هذا القرار الانتهازي، وأن عمله هذا سيكون نقطة تحول تعكس اتجاه مساره المتصاعد طوال أكثر من عقدين. وسيكون من الصعب عليه، مع استيقاظ أوروبا عسكرياً، أن يستكمل حلم الإمبراطورية الروسية، أو يستعيد حلف وارسو. ومع كل ما يبدو عليه المشهد من وضوح لهذه الناحية، إلا أننا يجب أن ننتظر تطورات المواجهة الصامتة بين العملاقين العالميين، الولايات المتحدة والصين، في المحيطين الهندي والهادئ، فالأزمة الأوكرانية ليست سوى العرض في هذه الدراما الكونية، أما المواجهة ففي خليج تايوان.
منذ عهد ترامب، تنبهت مواقع صنع القرار الأميركي إلى الصعود الكبير للتهديد الصيني، خصوصاً في المجال العسكري، وعدّته خطراً يتجاوز الروسي بمراحل، لا سيما أنه يتزامن مع زحف اقتصادي على “الحزام والطريق”، وبوجود زعيم ذي نزعة عدوانية وتوسعية على رأس السلطة في بكين. وعليه، بنَت واشنطن استراتيجية الدفاع الوطني الأميركي للسنوات الأربع المقبلة على أساس مفهوم “الردع المتكامل”، بدلاً من مفهوم “المنافسة الاستراتيجية” الذي كان متبعاً خلال العقدين الأخيرين. ويعني المفهوم الجديد، إجرائياً، تعزيز الردع النووي والتقليدي فائق التطور، للَجم الطموحات الصينية، وتحرير الموارد لصالح جهود التحديث الملحّة للتكنولوجيات العالية، والتأكد من قدرة الجيش الأميركي على هزيمة منافسيه، وتجنب هدر الموارد على الأنشطة اليومية والمصاريف التشغيلية للجيش الأميركي المنتشر في مناطق ليست ذات أهمية اليوم بالنسبة لأميركا، مثل أفغانستان والشرق الأوسط.
لكن مواجهة الصين بحزم تقتضي أيضاً تحرير واشنطن من مسؤولية أمن أوروبا، التي ضغط عليها ترامب لتأخذ دورا أكبر في الناتو، ووصل به الأمر إلى التهديد بسحب المظلة الأمنية، وكان يومئ إلى ألمانيا تحديداً بتصريحاته الفجة. لكن برلين تلكأت في الاستجابة، وقالت إنها ستخصص 2 في المئة من ميزانيتها للدفاع، لكن ليس قبل العام 2031.
إدارة بايدن ذهبت أبعد من ذلك، وانتقت بريطانيا التي تملك أقوى جيش في أوروبا، لترافقها في المواجهة مع الصين، وأبرمتا معاً اتفاقية أمنية مع أستراليا في المحيطين الهندي والهادئ. وقوضت، بكل راحة ضمير، صفقة عسكرية بين فرنسا وأستراليا، كأنما تقول لباريس إن مهمتها مع دول الناتو الأخرى، في مواجهة العدو الآخر، روسيا.
وفي خضم الأزمة الحالية ذاتها، طار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى ملبورن في أستراليا، لحضور اجتماع مع نظرائه من المحور الأمني الرباعي الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، ويهدف إلى إنشاء بيئة استراتيجية مع هؤلاء الحلفاء لمواجهة التهديد الصيني.
لقد كانت لحظة الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحظة انتباه أوروبا من غفلتها الطويلة التي تسببت فيها عقود السلام ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي عبّر عنها بتكثيف شديد، وزير الدفاع الألماني، عندما أعلن بذعر أن بلاده “عارية عسكرياً”. الغزو أيضاً أيقظ الأوروبيين من حالة الاستغراق في عسل التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، الذي لا يمكن ضمانه من دون القوة العسكرية، ولفت نظرهم إلى سبب الفشل أمام روسيا في غزواتها وحروبها السابقة، وهو افتقادهم للسلاح الذي يرغمه على تقديم تنازلات.
صحيح أن الموقف الفرنسي من وجود قوة دفاعية خاصة بها، معروف منذ أيام ديغول في الخمسينيات، وأن ماكرون حثّ أوروبا العام 2018 على تشكيل جيشها الخاص، محذراً من مخاطر “القوى السلطوية الصاعدة”. إلا أن موقف برلين المتراخي جعل نداءاته صرخة في وادٍ. لكن الأمور تغيرت كلياً الآن، ووضع المستشار الألماني مبلغ المئة مليار يورو في الصندوق العسكري، وهو مبلغ يفوق كل ما تنفقه روسيا على جيوشها في سنة واحدة. ومع قرار ألمانيا اقتطاع ما نسبته 2 في المئة من ميزانيتها للدفاع على نحو مستمر، واتخاذ إجراءات أخرى، مثل تحويل صفقة مخططة مسبقاً لشراء طائرات إف-18، إلى صفقة لشراء طائرات إف-35 الهجومية الفائقة، وتقديم أسلحة لأوكرانيا، فإننا نستطيع القول إن وزارة الدفاع الألمانية تحولت إلى وزارة حرب.
في خلال فترة وجيزة، ستصبح ألمانيا القوة العسكرية الأبرز في أوروبا، والحصن الأصلب في طريق موسكو، وسيتبع ذلك بالتأكيد اتخاذها مواقع أمامية في المناطق الساخنة، سواء في أوروبا الشرقية أو حتى الشرق الأوسط. بعبارة أخرى، ستلعب دوراً هجومياً في الصراعات الدولية لعقود مقبلة، وعلى رأسها الصراع مع روسيا، بعدما واظبت لعقود على اختيار مهمة “حفظ السلام” لقواتها المنتشرة على استحياء هنا وهناك.
لا يتسع المقام هنا لتعداد خسائر أخرى قد يتكبدها قيصر روسيا، مثل خسارة علاقاته الاقتصادية مع أوروبا وألمانيا على وجه التحديد، والتي توازي خطورة العقوبات الاقتصادية، أو تحالفه الناشئ مع تركيا، التي سيتوجب عليها خوض حروب الناتو، ولا الهند التي انخرطت مع واشنطن في التحالف الأميركي ضد الصين، لكنها تستمد معظم عتادها العسكري من روسيا.
لكننا يجب أن نحذر الاجتزاء. فالأحداث الخطيرة الحالية تجري في سياق أوسع، وكما أن واشنطن تولي كل اهتمامها للصين حالياً، فإن هذه الأخيرة ما زالت أيضاً تولي جلّ انتباهها للولايات المتحدة. لكن، في اللحظة التي يصبح فيها الصراع جدياً، ستزول الفواصل الكرتونية بين الحيزات التي تبدو متمايزة حتى هذه اللحظة، وسينشأ في الحال جسر اعتماد متبادل صينيّ روسيّ، وحينها لن نتحدث عن حرب تستحضر شبح ستالين فحسب، بل عن مواجهة غربية شاملة مع قطب عالمي جديد بوجهين عدوانيين، أحدهما للزعيم الصيني تشي والآخر لبوتين. وعلينا أن نتذكر أخيراً أن “نقطة التحول” التي يتحدث عنها الخبراء باستفاضة في كل مكان، إذا ما كانت هناك نقطة من هذا النوع، هي بالتعريف لحظة يشاهَد فيها الماضي والحاضر والمستقبل معاً.
المدن
————————

أوكرانيا: الغرب في نشوته البطولية/ شادي لويس
أوكرانيا: الغرب في نشوته البطولية انعكاس تظاهرة، ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، في زجاج المدخل لمقر الأمم المتحدة في نيويورك (غيتي)
ببطء، تتقدم طوابير الدبابات الروسية بطول عشرات الأميال، مخترقة الأراضي الأوكرانية. يوظف بوتين تكتيكاً من عصر السوفيات. تكتيك مُتحفيّ يعود إلى عقدي الخمسينات والستينات، إلى زمن اجتياح بودابست في 1956، وبعدها باثني عشر عاماً اجتياح براغ. بالكاد يستخدم الروس ترسانتهم الجوية الهائلة، تلك التي جربوها في سوريا بلا رادع.
الحروب من أعلى، معارك الدرونات وألعاب الفيديو، الحروب كما يعرفها القرن الحادي والعشرون محجوزة لأناس آخرين في قاع العالم، وعلى وجه التحديد في منطقتنا. تغزو موسكو بلداً “شقيقاً”، وتبدو قيادتها حريصة ألا تقع خسائر فادحة بين المدنيين. بوتين، المهووس بسردية التاريخ، يرى الأوكرانيين روس مارقين، لكنهم روس في النهاية، وهو لا يبغي تدمير أخوة عمرها ألف عام أسطورية. فخسائر أفدح ستعني صعوبة إخضاع أوكرانيا في المدى الطويل وكذلك تنصيب نظام موالٍ بالقوة. يخشى الروس أيضاً ردّ فعل أكثر حدة من الغرب، فلا أحد يريد أن يرى شلالات دم في أوروبا.
“روسيا قوة إقليمية تمثل تهديداً لبعض جيرانها المباشرين، وهذا لا يتأتى من شعورها بالقوة، بل على العكس، من شعور بالضعف”، صرّح بذلك الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في مؤتمر للأمان النووي في لاهاي العام 2014. بالفعل، الذراع الطويلة لموسكو لم تعد قادرة على الوصول أبعد من حدودها المباشرة. قوات “الناتو” تطوق روسيا من الجهات كافة. بولندا، المقر السابق لحلف وارسو، تستضيف العدد الأكبر من تمركزات الحلف الأطلسي. الحرب الأوكرانية، حرب إقليمية بأضيق معنى للكلمة، دلالة إضافية على محدودية دائرة تأثير موسكو.
تخسر روسيا المعركة قبل أن تبدأ. الغرب الذي بدأ متردداً، سرعان ما اجتاحته نوبة من الحماس المنتشي. الامبراطورية من القوة بحيث أنها لا تحتاج أن تخوض حرباً، ولا حتى أن تلوح بها. بضغطه على مفتاح نظام “سويفت”، يغرق النظام المالي الروسي في عزلة شبه كاملة. تحسباً للعقوبات، راكمت موسكو احتياطات هائلة -للمفارقة الساخرة- بالدولار الأميركي، لكنها الآن لا تستطيع الوصول إلى نصفها حتى. الغرب أوسع من دلالته الجغرافية، من أستراليا في الجنوب، إلى كندا في الشمال، مروراً ببرلين وطوكيو وسنغافورة، تُفرض العقوبات على روسيا، وتُغلق المجالات الجوية أمام طائراتها. الاتحادات الرياضية، موقع “يوتيوب”، شركات الانتاج السينمائي، كروت الائتمان “فيزا” ومعها “ماستر كارد”، دور الأوبرا وفرق الموسيقى الكلاسيكية والجامعات وشركات الشحن البريدي،.. الجميع ينضم إلى نشوة المقاطعة.
العواصم الغربية التي ما زالت تتخبط في محاولة الخروج من محنة الوباء، لتجد الأسواق على أعتاب أزمة تضخمية كبيرة وأمامها مواطنون ساخطون، تتحين في الاعتداء الروسي فرصة للملمة نفسها. تغدو الحرب الأوكرانية معركة بين الخير والشر. يسميها الرئيس الأوكراني “حرب النور مع الظلمة”. أما الأوكرانيون، فهم في الخطوط الأمامية لإنقاذ الحضارة. وسائل الإعلام الغربية تنطلق في حملة دعائية بمصطلحات بطولية، تشبه لغة الحرب العالمية الثانية، لتمجيد المقاومة، كييف هي لينينغراد جديدة.
القارة العجوز التي أرّقتها “أزمات” اللاجئين، وأرّقتها أكثر صورتها أمام نفسها، أنانية وخائفة ومنكفئة على ذاتها، تستعيد قيمها مرة أخرى وتعود الحياة إلى قلبها الإيديولوجي. حملات واسعة للتبرع وجمع المعونات، تنطلق بطول القارة وعرضها في خلال أيام. الحكومة البريطانية تغير قواعدها للهجرة بشكل استثنائي في ليلة. الأذرع المفتوحة لأخوية الشَّعر الأشقر والعيون الزرقاء، تسترجع لأوروبا إيمانها بنفسها، مبررة الوحدة التي مزقها “بريكست” أولاً، ثم حروب اللقاحات الأوروبية-الأوروبية والقيم الفردية والرؤى القومية الضيقة. في معركة أوكرانيا، يجتمع الغرب على مصير واحد، على إيمان أيديولوجي شبه مقدس بالذات، برسالة الغرب للعالم من أجل الدفاع عن قيم الحضارة. الشعور بالتهديد يغلبه شعور بالنشوة، مجد بطولية مجانية، يدفع ثمنها الأوكرانيون وحدهم. أما الامبراطورية فتثبت مرة أخرى أن هيمنتها شبه مطلقة.
المدن
——————————
التايمز: سياسة العقوبات لم تنجح في سوريا وستزيد بوتين خطورة
إبراهيم درويش
ال مراسل صحيفة “التايمز” في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن العقوبات على روسيا لا تكفي كما بدا من حالة سوريا.
وعلق قائلا إنه بالنسبة للسوريين الذين تجمعوا معا في خيامهم وسط الشتاء البارد، فإن القصف على كييف هو أمر فظيع يعرفونه. وبالنسبة للذين يعيشون في أجزاء أخرى من سوريا وفي المناطق الخاضعة لبشار الأسد، فإنهم سيراقبون جزءا مختلفا من الحرب الأوكرانية، أي العقوبات الغربية التي أعلن عنها في الأيام الماضي وأحدثت هزات في الاقتصاد الروسي.
فقد تشكلت طوابير طويلة -تذكر بأيام الاتحاد السوفييتي- أمام آلات الصرف الآلي، كما بدا واضحا أن هذه العقوبات بدلا من وقف تصدير الغاز، فإنها تستهدف جوهر النظام المالي في روسيا والقائم على 640 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، والبنك المركزي الروسي. وبالنسبة للروس العاديين، كما في حالة السوريين العاديين وحتى البريطانيين العاديين لا يفهمون التفاصيل الدقيقة للعملات الورقية، ولكنهم يعرفون متى يجب عليهم الحصول على العملات الصعبة قبل أن تختفي في الثقب الأسود.
ويقول الناتو إنه لن يذهب إلى حربٍ مع روسيا من أجل أوكرانيا، ولكن سياسة العقوبات هي الأقرب للحرب، كما ثبت مرة بعد الأخرى في العقوبات التي فرضت على صدام حسين وسوريا التي شُلّ اقتصادها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، وما حدث لإيران منذ تمزيق دونالد ترامب الاتفاقية النووية عام 2018، وكوريا الشمالية التي تعيش عقوبات دائمة. ويقول سبنسر إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لديهم فريق كبير من الدبلوماسيين والمحامين الذي يقومون بدوزنة العقوبات كي تمنع الشحن بكل أنواعه والعملة الأجنبية والبروتوكولات المصرفية بحيث تحقق أكبر ضرر على الهدف، أي اقتصاد روسيا.
ويرى سبنسر أن الساسة الغربيين يؤمنون إيمانا قويا بالعقوبات، لدرجة أن أحدهم لم يفكر ولا لحظة إن كانت وسيلة ناجعة وناجحة، ولا تؤدي إلا إلى زيادة فقر الملايين من المواطنين الذين لا رأي لهم في سياسات قادتهم.
وهناك الكثير من الناس خارج الأحزاب السياسية يطرحون هذه الأسئلة، ولكن نُظر إليهم كمدافعين عن الأسد أو صدام، رغن أن بعضهم كذلك. ولكن المعاناة للسوريين العاديين منذ عشرة أعوام بسبب الحرب، أو تصميم نظام كيم جونغ- أون، تدعو الساسة للتوقف لحظة والتفكير.
ومسألة العقوبات ليست متعلقة باليمين أو اليسار، فعدد كبير من أكبر الناقدين اليساريين للعقوبات التي فرضت على العراق وسوريا ولاحقا إيران، كانوا من المدافعين عن فرضها على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا في الثمانينات من القرن الماضي. وعلى جانب اليمين، فالدفاع الذي رفعته مارغريت تاتشر عن سياسة “التواصل البناء” مع جنوب أفريقيا والتي ترى أن عقوبات قاسية ستدفع إلى المعاندة. وقد نسي حزب المحافظين البريطانيين كل هذا، عندما تحمس لفرض العقوبات على نظام صدام حسين. ولم تؤد العقوبات على صدام إلى قبوله بشروط الغرب أو الإطاحة به. وظل بشار الأسد في مكانه، فرجل عبّر عن استعداد لقصف شعبه حفاظا على مملكته، لن تحركه صور طوابير الخبز.
ويضيف سبنسر أن هذا هو الدرس الأول الذي يجب علينا تطبيقه في عقاب بوتين. فالذين يعتقدون أن العقوبات ستؤدي إلى تغيير النظام في موسكو لم يتمعّنوا بالتاريخ، إلا إذا كنت متفائلا بقوة الديمقراطية الروسية أكثر مما هي عليه. ولم تكن جنوب أفريقيا ديمقراطية بالمعنى الحقيقي، إلا أن الأفريقيين كان لديهم اختيار فوق حكومتهم، ويأخذون بعين الاعتبار تمتعتهم بالألعاب الرياضية الدولية مثل الكريكيت والرغبي. ولن يكون للروس فرصة كهذه في المستقبل القريب.
كل هذا لا يعني أن العقوبات لا مكان لها في ترسانة الدبلوماسية، خذ مثلا إيران، نظامها وبرنامجها النووي، اللذين يعدان من أكثر المسائل الخلافية في السياسة الأمريكية حاليا، وهذا بالطبع مرتبط بالعلاقة العاطفية مع إسرائيل. وسواء دعمت الصفقة أم لا، فالدول الأوروبية التي تواجه بوتين الآن تدعمها، فاستخدام العقوبات أثبتت أنها محرك رئيسي للدبلوماسية مع إيران.
وحتى خارج البرنامج النووي، فقد أضعفت العقوبات على البنوك والأفراد ذات الصلة بالحرس الثوري من قدرته على نقل الأسلحة الدقيقة للميليشيات الشيعية في المنطقة. وربما كان لها هذا الأثر عندما أرفقت بغارات جوية إسرائيلية على قوافل السلاح التي عبرت سوريا. ويجب أن تكون هذه النقطة حاضرة في الأذهان عندما تبدأ العقوبات بترك مفعولها على روسيا. وهل هي جزء من خطة أوسع لوقف استخدام روسيا القوة؟ وهل ستكون مثل العقوبات على إيران، جزءا من سياسة العصا والجزرة التي تسمح بعرقلة تقدم إيران برنامجها النووي والزعم في النهاية أنها حققت انتصارا محدودا؟
وقال الكاتب إن مقولة شائعة منسوبة للحكيم العسكري الصيني “سان تزو” بدأت بالانتشار في الأيام الأخيرة، حيث جلس بوتين على طاولته الطويلة بشكل أثار تساؤلات حتى الصقور، إن كانت سياسة الاحتواء الغربية المتشددة ربما تحولت لتهديد مستقبلي، خلافا لما قاله الحكيم الصيني: “لو انسحب عدوك، عبّد الجسر له بالذهب”.
وإذا لم ينجح بوتين في حملته على أوكرانيا، فسيصبح خطيرا كما في حالة صدام حسين بعد حرب إيران. وقال بوتين: “ما الحاجة للعالم إن لم تكن روسيا فيه؟”. ولكن لا يوجد ما يشير إلى الإطاحة به. فسياسة عقوبات مصممة لعزله لا قيمة لها ومحفوفة بالمخاطر. وسياسة عقوبات تهدف لإعادة روسيا إلى المجتمع الدولي أفضل من حصر روسيّ محاصر في ملجئه ومسلح بالأسلحة النووية ويؤمن بالهدف الإلهي.
القدس العربي
—————————-
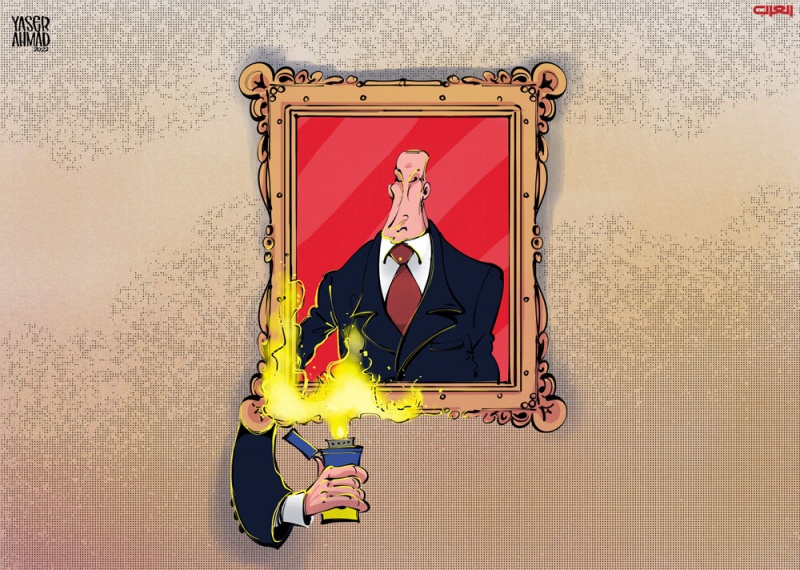
بايدن يرسم حدود بوتين في أوروبا..أوكرانيا فقط
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة. لكنه جدد التاكيد على أنه لن يرسل قوات للقتال ضد الروسي في أوكرانيا.
وقال بايدن في خطاب “حالة الاتحاد” السنوي، الذي هيمنت الحرب الروسية بأوكرانيا على جزء كبير منه، إن قوات بلاده لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا، لكنها ستحول دون تقدم القوات الروسية غربا نحو دول أوروبية أخرى، كما شدد على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف “قواتنا لم ولن تدخل في نزاع مع القوات الروسية في أوكرانيا. نحن لن نرسل قواتنا إلى أوروبا كي تقاتل في أوكرانيا، بل لحماية حلفائنا في الناتو في حال قرر بوتين مواصلة التحرك نحو الغرب”. وقال إنه “تمّت تعبئة القوات البرية والأسراب الجوية والسفن الحربية للدفاع عن دول الناتو، بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا”.
وذكر بأن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات شديدة على روسيا، ومنعوا وصولها إلى التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن “العالم الحر والدول الأوروبية -وحتى البلدان الأخرى مثل سويسرا- بدأوا فرض عقوبات على روسيا”.
وأضاف أن حرب روسيا على أوكرانيا كانت “متعمدة وغير مبررة”، مؤكدا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير “رد الفعل القوي والموحّد للغرب” إزاء حرب روسيا على أوكرانيا. وقال: “ليست لديه أدنى فكرة عما ينتظره”، مضيفاً أنّ بوتين “ديكتاتور” بات “معزولاً أكثر من أيّ وقت مضى”.
وأضاف بايدن أن ما يقوم به “ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم”، مشدّداً على أنّ “بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء”. وتابع أنّ الرئيس الروسي “كان يظنّ أن الغرب وحلف شمال الأطلسي لن يردّا”، لكن “في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديمقراطيات أنها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن”.
وفي إشارة إلى بوتين، حذّر الرئيس الأميركي من أنه “إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنهم يتسبّبون في مزيد من الفوضى”. وأضاف “ربّما يطوّق بوتين كييف بالدبابات لكنّه لن ينجح أبدا في الاستيلاء على قلوب الشعب الأوكراني وأرواحهم ولن يقضي على حبّهم للحرية أبداً”. و”سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل”.
وتوعّد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة “يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة”، والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة أعمال غير شريفة.
وأعلن الرئيس الأميركي في خطابه، أن الولايات المتحدة ستغلق الأجواء الأميركية في وجه كل رحلات الطيران الروسي. وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي “يتداعى وكل اللوم على بوتين”، لكنه طمأن بأن هذا الوضع لن يؤثر على اقتصاد أميركا، حيث قال: “سنحمي المستهلكين والشركات الأميركية من تداعيات العقوبات المفروضة ضد روسيا”.
ويأتي إعلان حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، أنه يجري مناقشات مع الولايات المتحدة من أجل تطبيق حظر على الرحلات الروسية، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وكان كل من الاتحاد الأوروبي وموسكو قد حظرا السفر الجوي بينهما بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، في خطوة تسببت بحجب المسارات الجوية بين الشرق والغرب، ولم تستبعد واشنطن بعد تطبيق قرار مماثل بحق روسيا.
من جهة ثانية، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأربعاء، بدعم ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قائلاً: “لم يعد هناك وقت للحياد”.
وفي كلمة مصوّرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد زيلينسكي أن روسيا لا تستطيع تحقيق النصر في أوكرانيا عبر إطلاق القذائف والصواريخ.
وبالرغم من أن الأجواء العامة في أوروبا يسودها تضامن غير مسبوق مع أوكرانيا، الدولة غير العضو في نادي الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ما زال هناك تردد أوروبي بضمّ البلد إلى معسكرهم دون شروط.
والاثنين، أعلن زيلينسكي أنه وقّع على طلب رسمي لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، طالباً من الاتحاد السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور، بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة غزو القوات الروسية.
وحثّ الرئيس الأوكراني الثلاثاء، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، على إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال إن “الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، هذا أمر مؤكد. بدونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة”.
——————————–
روسيا تعبت من كونها «الولد الطيب»/ دميتري بابيتش
عندما خاطب الرئيس فلاديمير بوتين الشعب الروسي والأوكرانيين، يوم الخميس الماضي، معلناً بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، تغلّب اليأس العميق على الكثير من الروس. هل أُصيب الرئيس بالجنون؟ قد تكون هذه الفكرة ترددت في أذهان كثيرين. ناهيك بفكرة أخرى، مفادها: «لقد تبين أنه مختلف تماماً عمّا كنا نظن». وقد يكون البعض ذهب إلى أن تلك الروح السلبية التي رسمت ملامحه لفترة طويلة في وسائل الإعلام الغربية قد تكون صحيحة.
اتضح أن زيلينسكي ليس مستقلاً…
لكن في اليوم التالي، بدأ الوضع يتغيّر في الرأي العام. بدأ الروس يفهمون منطق بوتين. واللافت هنا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يُطلق عليه في الغرب لقب «بطل المقاومة» في مواجهة روسيا، هو الذي ساعد الروس كثيراً في تلمس الحقيقة. ففي اليوم التالي بعد بدء العملية العسكرية أعلن زيلينسكي أنه مستعد للمفاوضات بشأن «حياد أوكرانيا»، أي حول إدخال التعديلات اللازمة في دستور أوكرانيا لتحديد قواعد السياسة الخارجية للبلاد، بما يستبعد نهائياً فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وكان من الطبيعي أن يأتي الرد من جانب بوتين سريعاً ومحدداً: «نعم، بالطبع». إذ لا يخفى أن هذا كان المطلب الرئيسي لروسيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا حالياً) منذ ديسمبر (كانون الأول). كانت الملفات المطروحة على الطاولة عدم تمدد «الناتو» شرقاً نحو أوكرانيا، وعدم نشر أسلحة وصواريخ نووية أميركية وبريطانية في هذا البلد. لكن الجواب من «الناتو» والولايات المتحدة ومن كييف كل تلك الفترة تميّز بالتعنت والرفض. والآن، بعد مرور يوم واحد على إطلاق العملية العسكرية الروسية، يَعِد زيلينسكي ببساطة بحل المشكلة: «ستكون أوكرانيا محايدة»!
شكّلت موسكو على الفور وفداً للتفاوض مع ممثلي زيلينسكي وأرسلته إلى بيلاروسيا، وهي منصة تقليدية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2015.
لكن زيلينسكي صمت فجأة، ولم يعد يرد على اتصالات قنوات الوساطة. بل اختفى لبعض الوقت، رغم أنه كان قد وعد الأوكرانيين في اليوم الأول للقتال، بالظهور مرة كل ساعة على الإنترنت والتعليق على الأحداث.
بعد ساعات من الإشارات الواعدة حول الاستعداد لالتزام الوضع المحايد، عاد زيلينسكي للظهور في بث على الهواء، لكنه كان محاطاً هذه المرة، بـ«مساعديه» الكارهين للروس والمعروفين بمعتقداتهم القومية الأوكرانية. وبعد ذلك لم يقل زيلينسكي أي شيء عن مبدأ الحياد. وفي اليوم التالي، قالت السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، جين ساكي، إن «الولايات المتحدة قدمت المساعدة في تأمين زيلينسكي».
أصبح كل شيء واضحاً للروس. زيلينسكي ليس مستقلاً. إنه ينفّذ إرادة «القيّمين عليه». القوميون الأوكرانيون و«المستشارون الأمنيون» الأميركيون. لجعله مستقلاً، كان يجب طرد هؤلاء القيّمين. وهذا لا يمكن القيام به إلا من القوات الروسية.
بعد ذلك، تم استئناف عمليات القوات الروسية في أوكرانيا بعدما أوقفها بوتين لعدة ساعات لتشجيع مسار المفاوضات. تم استئنافها بدعم أكبر من الشعب الروسي. وبعدما أدرك الروس أن بوتين «ليس مجنوناً». لكنه سياسي وجد نفسه مضطراً إلى السعي للحصول على اتفاق مع نظام عاجز عن اتخاذ قرار. لذلك كان لا بد من الحصول على الاتفاق عبر استخدام القوة.
من الصعب علينا أن نرى هذا
هل يصعب على الروس مراقبة كيف تسير الحرب في أوكرانيا؟ نعم، إنه أمر صعب للغاية. الأوكرانيون والبيلاروس هم أكثر الشعوب على وجه الأرض قرباً من الروس. وقد تحول معظم الأوكرانيين والبيلاروسيين إلى استخدام اللغة الروسية في القرنين التاسع عشر والعشرين. بطبيعة الحال، مع مرور أكثر من 400 عام من العيش المشترك في دولة واحدة، بات لدى الأوكرانيين والروس ملايين العائلات المختلطة. لقد أعاد الروس، مع الأوكرانيين، بناء أوكرانيا بعد الدمار الذي ألحقه الألمان بأوكرانيا ومناطق أخرى من الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية. وخلال عهد الاتحاد السوفياتي، كان الروس والأوكرانيون يعدّون أكثر الشعوب ولاءً وموثوقية، وتشكلت الكوادر القيادية للحزب الشيوعي السوفياتي والـ«كي جي بي» والجيش من الروس والأوكرانيين. (كان بريجنيف وخروتشوف من الروس الذين عاشوا معظم حياتهم في أوكرانيا، بينما كانت والدة غورباتشوف وجميع أقاربها من الأوكرانيين). على مدى عقود كثيرة من العيش معاً. اعتاد الروس على عدم وجود فوارق تميزهم عن الأوكرانيين.
لذلك، نحن بالطبع، نشعر بالخوف والأذى عندما نرى كيف يفجر الجنود الأوكرانيون الجسور، ويدمرون الطرق التي تعبرها القوات الروسية.
نشعر بالحزن الشديد لرؤية سكان كييف وهم يلجأون إلى مترو الأنفاق بسبب التفجيرات. لقد بنى الروس والأوكرانيون، معاً وعلى مدى سنوات طويلة، هذه الجسور والطرق، وهذا المترو.
لذلك، الوقت ليس في صالح روسيا. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. ولذلك تحديداً، فإن وفد المفاوضين الروس ذهبوا إلى منطقة غوميل في بيلاروسيا لإجراء المحادثات مع المفاوضين الأوكرانيين.
لوكاشينكو أصبح حليفاً لروسيا بفضل الغرب…
لا توجد أسباب كثيرة للتفاؤل بالتوصل إلى توافقات في هذه المفاوضات. وافق زيلينسكي مرة أخرى على مفاوضات حول الوضع المحايد. هذه المرة جاءت الموافقة بعد محادثة هاتفية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف السابق لزيلينسكي، وحليف سلفه بيترو بوروشينكو. وحليف روسيا حالياً.
نعم، هكذا. فرئيس بيلاروسيا كان يدعم أوكرانيا، خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب التي شنها الجيش الأوكراني ضد منطقة دونباس الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا. طوال الفترة من 2014 إلى 2020 قدّم لوكاشينكو أشكال الدعم للقيادة الأوكرانية. وكانت لديه لقاءات ودية للغاية مع الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، الذي بدأ بقصف دونباس عقاباً لهذه المنطقة لأنها رفضت الاعتراف بالانقلاب الذي وقع في فبراير (شباط) 2014 والذي أسفر عن إطاحة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المنتخب قانونياً في 2010، وهو بالمناسبة من منطقة دونباس.
وبسبب انتمائه إلى هذه المنطقة، فقد صنفته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لسنوات كثيرة على أنه «موالٍ لروسيا»، منذ ظهوره في السياسة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى الانقلاب الدموي غير القانوني الذي أُطلقت عليه تسمية ثورة الميدان في 2013 – 2014.
اختلف لوكاشينكو مع أوكرانيا فقط في عام 2020 عندما أيّد زيلينسكي، بناءً على أوامر من الغرب، محاولة الإطاحة برئيس بيلاروسيا الذي هو بالفعل استبدادي (لا يشبه بوتين) من قوى المعارضة البيلاروسية الموالية للغرب والكارهة لروسيا. فشلت محاولة الانقلاب البيلاروسية، على الرغم من دعم أوكرانيا، وأصبح لوكاشينكو حليفاً قسرياً لروسيا التي قدمت لمينسك مساعدات مالية عاجلة في لحظة صعبة للغاية عام 2020.
بوتين الليبرالي السابق
الساعي لحلول وسط
ما الذي تعكسه حقيقة أن بوتين لم يسعَ للانتقام من لوكاشينكو، الذي خان روسيا لسنوات عدة، من خلال علاقاته الوثيقة مع نظامي بوروشنكو وزيلينسكي المعاديين لروسيا؟
الحقيقة أن بوتين بطبيعته سياسي قادر على إبرام صفقات، مستعد للمفاوضات وإيجاد التسويات الضرورية. لسنوات كثيرة في عهد بوتين، حاولت روسيا التفاوض مع الغرب -مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي- على أساس الحلول الوسط. في بداية حكم بوتين، دعمت روسيا الولايات المتحدة في قتالها ضد «طالبان» في أفغانستان في عام 2001، وفي عام 2003 أغلقت روسيا طواعيةً قواعد الحرب الباردة في فيتنام وكوبا. في عام 2004 عندما توسع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ليشمل الجمهوريات السوفياتية السابقة مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بالإضافة إلى الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب شرقي أوروبا (بلغاريا ورومانيا)، لم يكن لدى روسيا مقاومة كبيرة لهذا التوسع، على الرغم من أنها أدانته من حيث المبدأ، كونه يضع «خطوطاً فاصلة في أوروبا».
لكن كل هذه التنازلات لم تقابَل بامتنان من الغرب، بل على العكس من ذلك، أثارت فقط شهيته لتقليص حدود «وسادة الأمن» حول روسيا.
منذ خطاب ميونيخ في عام 2007 الذي أعرب فيه بوتين عن استياءٍ من توسع «الناتو»، أصبحت موسكو أكثر صراحة في مقاومة توسع «الناتو» من خلال الوسائل الدبلوماسية. لكن الغرب لم ينظر إلى هذه المقاومة على أنها قوة جادة، بل إن الغرب كان يبدو غاضباً أحياناً بسبب اعتراضات روسيا. حتى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في عام 2014 كان ينظر إليها من الغرب على أنها مجرد حدث عابر أو صعوبة مؤقتة، لا تعكس استعداداً جدياً للدفاع عن مصالح روسيا، بقدر ما تدل على حنين لدى بوتين لإعادة الروح إلى الاتحاد السوفياتي.
نهاية إجبارية للحلول الوسط
لماذا أطلق بوتين، الذي سعى لفترة طويلة إلى حلول وسط، مثل هذه العملية الحاسمة والحازمة في أوكرانيا؟ تخيّل مثل هذا النموذج النفسي: يأتي صبي (روسيا) إلى مدرسة جديدة (العالم الغربي الحديث) ترافقه سمعة سيئة منذ البداية. إما بسبب السلوك السيئ للوالدين (ستالين وبريجنيف)، وإما ببساطة بسبب غطرسة وعدوانية زملاء الدراسة الجدد. يحاول الصبي التفاوض وتكوين صداقات، لكنّ زملاءه في الفصل أنفسهم يعزلونه ويتنمرون عليه ويعلنون أنه «أحمق».
ماذا يبقى لدى الصبي؟ إنه يوجّه ضربة قوية إلى الجاني الأكثر شراسة. الجاني على وجه التحديد هو الأكثر إثارة للاشمئزاز والاحتقار، وليس بالضرورة أن يكون الأقوى.
في الواقع تُظهر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نوعاً من الاحتقار لأوكرانيا. وقد دلّ رفض الدول الغربية لإرسال قوات لمساعدة أوكرانيا في وقت مبكر على أن هذه الدول نفسها ما زالت تضع الأوكرانيين «على نفس المستوى» مع الروس. (في الشكل واللهجة فإن الروس والأوكرانيين أنفسهم بالكاد يميّز بعضهم بعضاً). وهذا هو بالضبط النظام الأوكراني الذي يتلقى ضربة في رأسه، لم يكن ليتوقعها.
ما نتيجة ضربة يوجهها فتى معزول تنمّر الجميع عليه؟ إحداث صدمة؟
يتساءل الأولاد الذين يضايقونه: ربما «الجديد» شرير حقاً، وقوي مثل والده بريجنيف وجده ستالين؟ ربما من الأفضل عدم مضايقته بعد الآن؟ إن عملية إعادة التفكير هذه هي التي تجري الآن في الغرب. بعد كل شيء، لسنوات كثيرة، وجّهت بولندا ودول البلطيق اتهامات متواصلة لروسيا بأنها تعد للهجوم عليها. لكن يبدو أن هذه البلدان في الواقع لم تكن خائفة من روسيا، بدليل أنها كانت تكيل الإهانات لبوتين. ربما تفكر حالياً بأن الأمر قد ينتهي بشكل سيئ من الآن فصاعداً.
يمكن لبوتين نفسه أن يذكّر محاوريه: عندما اقترحتُ نظاماً أمنياً جديداً في أوروبا، وعدتكم، بأننا إذا لم نتلقِ رداً على مطالبنا سوف نضطر إلى اللجوء لـ«رد عسكري – سياسي». لقد حصلتم عليه الآن.
* خبير سياسات،
المعلق السياسي في وكالة «روسيا سيغودنيا»
الشرق الأوسط
——————————
خبير بريطاني للجزيرة نت: هذه أخطاء الجيش الروسي بأوكرانيا والحرب الطويلة لن تخدم بوتين
3 أهداف لبوتين من هذه الحرب ويريد تحقيقها بشكل سريع وحاسم، وهي إسقاط الحكومة الأوكرانية المنتخبة وتنصيب أخرى موالية لموسكو، ثم إجبار أوكرانيا على التخلي عن مطالبها بالانضمام لحلف الناتو، ومنع انضمامها للاتحاد الأوروبي.
جون لوف مدير مشروع أبحاث “روسيا وأوراسيا” في معهد “تشاتام هاوس
أيوب الريمي
لندن- تتدحرج الحرب الروسية على أوكرانيا نحو تطورات لم يكن يتوقعها الكثير من المراقبين والمحللين، وأصبح الوضع من الخطورة بشكل يجعل التكهن بمآلاته مهمة صعبة.
ويترقب العالم ردود الفعل الصادرة من موسكو أو من العواصم الغربية، ويتساءل: هل تسير في اتجاه مزيد من التصعيد، أم سيكون هناك مجال للتفاوض وإنهاء الحرب؟
في هذا الحوار مع جون لوف، مدير مشروع أبحاث “روسيا وأوراسيا” في معهد “تشاتام هاوس” (Chatham house) في لندن، يكشف الباحث البريطاني أسباب الحرب الروسية على أوكرانيا، وما هي الأخطاء التي قام بها الفريق العسكري للرئيس فلاديمير بوتين قبل إطلاق العملية، وتوقعاته بشأن مصير هذه الحرب وتأثيرها على العالم.
هل كانت روسيا تتوقع أن تطول الحرب كل هذه المدة؟
يظهر -من خلال أطوار المعارك وتفاصيلها اليومية- أن هيئة أركان الجيش الروسي استهانت بالجاهزية القتالية لقواتها، ولم تقم بالتعبئة كما يجب، أمام دفاع أوكراني شجاع وحازم نجح حتى الآن في إفشال الخطط العسكرية الروسية.
كان هدف روسيا، من خلال إعلان سحب جزء من قواتها من الحدود الأوكرانية قبل الغزو، إحداث حالة من الارتخاء في دفاعات الجيش الأوكراني، ثم بعد ذلك اعتماد تكتيك الحرب الخاطفة. لكن هذا التكتيك لم ينجح الآن لأن الحرب تطول أكثر وأكثر، مما يعني أنه سيكون على الجيش الروسي اللجوء لخطط أخرى تتطلب استقدام المزيد من الجنود، وقصف المدن الكبرى، في محاولة لكسر الإرادة التي أظهرها الجيش الأوكراني في مواصلة القتال على أكثر من جبهة ومازال محافظا على قاعدته وقيادة عملياته.
كما أن لجوء روسيا للقصف الكثيف، ولمزيد من الجنود على الأرض، سيعني المزيد من القتلى في صفوف المدنيين، وهذا يعني بالضرورة المزيد من العقوبات ضد روسيا.
ما الهدف الرئيس لبوتين من هذه الحرب؟
كان لبوتين 3 أهداف من خلال هذه الحرب، ويريد تحقيقها بشكل سريع وحاسم، وهي إسقاط الحكومة الأوكرانية المنتخبة بشكل ديمقراطي وتنصيب أخرى موالية لموسكو، ثم إجبار أوكرانيا على التخلي عن مطالبها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ومنع انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لي، فإن الهدف الأساسي من هذه العملية هو تجريد أوكرانيا من استقلالها وسيادتها، وأن تصبح فقط دولة تابعة لموسكو دون أن يكون لها أي استقلالية في القرار.
ما تقييمكم لرد الفعل الغربي سواء الأوروبي أو الأميركي؟
الغرب عموما استفاق متأخرا، ولم يتحرك في الوقت المناسب وبطريقة صارمة وجدية، ولو أنه اتخذ الإجراءات اللازمة قبل انطلاق الحرب، فالأكيد أنها كانت ستدفع موسكو للتفكير كثيرا قبل الهجوم العسكري.
ولكن الآن، وبمتابعة كل العقوبات التي أقرتها الدول الغربية، في جميع المجالات، أتوقع أنها كفيلة بأن تجعل الاقتصاد الروسي يجثو على ركبتيه بسبب الخسائر التي تكبدها وسيتكبدها الأيام المقبلة، مع تلويح الغرب بمزيد من العقوبات.
هل العقوبات الغربية قادرة فعلا على ردع روسيا؟
أعتقد أن العقوبات الحالية لن تظهر نجاعتها إلا في حال استمرت وربما قد تزيد حدتها، لحينها يمكن أن نسأل: هل ستؤدي هذه العقوبات ليس لوقف الحرب وإنما لإجبار النظام الروسي على تغيير سلوكه السياسي ومساره في التعامل مع القضايا الخارجية؟
في تصوري أنه لو طال أمد الحرب، وبدأت آثار العقوبات تظهر على الاقتصاد الروسي، وعلى الحياة اليومية للمواطن الروسي، حينها ستضع قيادة بوتين وشرعيته موضع مساءلة.
هل تعتقد أن بوتين استهان برد فعل الغرب والولايات المتحدة خصوصا، ولم يتوقع كل هذه العقوبات؟
نعم -إلى حد ما- هذا صحيح، يظهر أن التقديرات الروسية كانت تذهب في اتجاه، خصوصا لو نظرنا للتصريحات الأميركية والأوروبية قبيل انطلاق الحرب، والتي كانت تشي بأن ردة الفعل ستكون ضعيفة.
لكن -في المقابل الآن- ستقوم روسيا باتخاذ إجراءات مضادة خصوصا في قطاع الطاقة، وهو ما قد يجعل الحياة صعبة في بعض الدول الأوروبية، خصوصا لو قرر بوتين قطع إمدادات الغاز على أوروبا. وهناك دول تعتمد على الغاز الروسي لتوفير نصف حاجياتها وأكثر، وقطعه يعني أزمة طاقة حقيقية في بعض الدول الأوروبية.
ما التبعات الاقتصادية والسياسية للحرب على روسيا؟
التبعات الاقتصادية ستكون مدمرة بجميع المقاييس وكارثية على الاقتصاد الروسي، وربما قد تتضرر دول أخرى خصوصا لو اندلعت حرب للطاقة، وهذه العقوبات قد تذهب بعيدا ولن يبقى تأثيرها حبيس الاقتصاد، بل قد يؤدي إلى تغييرات سياسية حقيقية داخل روسيا وخارجها على المدى البعيد.
المصدر : الجزيرة
——————————–
توماس فريدمان: هذه السيناريوهات الثلاثة التي أتوقعها لنهاية الحرب على أوكرانيا
قد تكون الحرب في أوكرانيا -والتي تتكشف أحداثها أمام عيوننا الآن- أكثر الأحداث قدرة على إحداث تحول في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأخطر مواجهة يشهدها العالم منذ أزمة الصواريخ الكوبية.
هذا ما يراه المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأميركي البارز توماس فريدمان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية ويستشرف مآلات الحرب الروسية على أوكرانيا ويتلمس السيناريوهات المحتملة لنهايتها.
ويرى فريدمان أن هناك 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب، بعضها كارثي وبعضها ينطوي على تفاهمات يصفها بـ”القذرة”، وذلك على النحو التالي:
السيناريو الأول: كارثة مكتملة الأركان
يقول فريدمان إن ما يحدث الآن يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لقتل أكبر عدد ممكن من الناس وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية الأوكرانية للقضاء على استقلال البلد وحريته وثقافته ومحو قيادته.
وأشار إلى أنه إذا لم يغير فلاديمير بوتين تعاطيه أو يتمكن الغرب من ردعه فإن هذا السيناريو -الذي يتكشف الآن- قد يقود إلى ارتكاب جرائم حرب لم تشهد أوروبا مثيلا لها منذ عهد النازيين، ومن شأن تلك الجرائم أن تجعل بوتين وأعوانه وروسيا كدولة بلدا منبوذا في شتى أنحاء العالم.
ويرى الكاتب أن كل يوم يواصل فيه بوتين رفض وقف عملياته العسكرية في أوكرانيا يقرب العالم خطوة نحو أبواب الجحيم، على حد تعبيره، وأن مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر وحشية الجيش الروسي في أوكرانيا ستجعل من الصعب على العالم تجاهل ما يحدث هناك.
لكن التدخل -والكلام لفريدمان- قد يشعل أول حرب يستخدم فيها السلاح النووي في قلب أوروبا، وفي المقابل فإن السماح للرئيس الروسي بتحويل كييف إلى أنقاض وقتل آلاف المدنيين على النحو الذي جرى في حلب وغروزني سيمكنه من إنشاء أفغانستان أخرى في أوروبا، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى وتدفق اللاجئين.
ويشير المقال إلى أن أهداف الرئيس الروسي من الحرب لا تقتصر على الحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، بل يسعى إلى خلق “عالم روسي” يكون فيه الأوكرانيون والروس “شعبا واحدا”، وأن مهمته هي “إعادة جمع كل الناطقين باللغة الروسية في مختلف الأماكن التي كانت تنتمي في وقت ما إلى روسيا القيصرية”.
ويرى فريدمان أنه إذا حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الوقوف في طريق بوتين أو إذلاله بالطريقة التي انتهجوها مع روسيا في نهاية الحرب الباردة فإن الرئيس الروسي قد صرح بأنه مستعد للرد، فقد حذر قبل أيام -قبل أن يعلن وضع قوته النووية في حالة تأهب قصوى- من أن كل من يحاول الوقوف في طريقه فإن عليه أن يكون مستعدا لمواجهة “عواقب لم يرها من قبل”.
وفي هذا الصدد، أشار الكاتب إلى التقارير التي تشكك في سلامة بوتين العقلية، وكلها عوامل تشير إلى سيناريو مرعب.
السيناريو الثاني: تسوية قذرة
السيناريو الثاني الذي قد تؤول إليه نهاية الحرب -وفق توماس فريدمان- هو أن يتمكن الجيش والشعب الأوكرانيان من الصمود لفترة كافية ضد الحرب الروسية الخاطفة، وأن تتمكن العقوبات الاقتصادية من إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الروسي على نحو يحمل كلا طرفي الحرب على السعي للتوصل إلى تسوية “قذرة”، على حد وصف الكاتب.
ويتوقع أن تشمل تلك التسوية وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية مقابل تنازل أوكرانيا رسميا عن المناطق الأوكرانية الشرقية الواقعة الآن تحت سيطرة روسيا، إضافة إلى تعهد رسمي صريح من كييف بعدم الانضمام إلى الناتو.
وفي السياق نفسه، توافق الولايات المتحدة وحلفاؤها على رفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضوها مؤخرا على روسيا.
ولا يرجح فريدمان أن يتحقق هذا السيناريو نظرا لعدة عوامل، منها: أنه يتطلب إدراك بوتين عدم قدرته على تحقيق رؤيته القاضية بإعادة استيعاب أوكرانيا في الوطن الأم روسيا رغم الثمن الباهظ الذي دفعه على صعيد اقتصاده ودماء جنوده الذين سقطوا في الحرب.
السيناريو الثالث: الخلاص
أما السيناريو الثالث والأخير -والذي يراه فريدمان الأفضل رغم كونه الأقل احتمالا- فهو أن يهب الشعب الروسي بشجاعة دفاعا عن حريته كما فعل الشعب الأوكراني، ويخلص المنطقة من الحرب من خلال عزل بوتين من منصبه.
ويتوقع الكاتب أن العديد من الروس قلقون من أنه طالما أن بوتين زعيم بلدهم فلن يكون لديهم مستقبل مشرق، وقد عكس ذلك نزول آلاف منهم إلى الشوارع، للاحتجاج على حربه المجنونة ضد أوكرانيا رغم ما ينطوي على ذلك من مخاطر على سلامتهم الشخصية.
ويرى فريدمان أنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه الجزم بدلالة الاحتجاجات الشعبية الروسية ضد حرب بوتين على أوكرانيا فإنها تدعو إلى التساؤل عما إذا كان الشعب الروسي قد كسر حاجز الخوف، وما إذا كانت الهبة الشعبية قادرة على إنهاء حكمه في نهاية المطاف.
ويخلص الكاتب إلى أن استمرار بوتين في حربه التي تدك المدن الأوكرانية سيدفع روسيا إلى سجن كبير نظرا للعزلة الدولية التي ستفرض عليها، وأن أمام الشخصيات المتنفذة في روسيا والشعب الروسي ككل خيارين، إما التعاون للإطاحة ببوتين أو ينتهي بهم المطاف في العيش معه في بلد معزول دوليا.
المصدر : نيويورك تايمز
————————–
زهرة “عباد الشمس” تغزو شبكات التواصل.. باتت “رمزاً عالمياً” للتضامن مع أوكرانيا، وهذه قصتها
عربي بوست
باتت زهرة عباد الشمس، التي تحتل مكانةً ذات مغزى في قلوب العديد من الأوكرانيين، “رمزاً عالمياً للمقاومة والوحدة والأمل”، وأصبحت تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بدء الغزو الروسي قبل أيام.
حيث أضاف آلاف الأشخاص بجميع أنحاء العالم، في الأيام الأخيرة، رمزاً تعبيرياً عن عباد الشمس الأصفر الساطع إلى ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتدوا عباد الشمس –التي تُعتبر “الزهرة الوطنية” للأوكرانيين- في شعرهم وعلى ملابسهم، طبقاً لما أوردته صحيفة Washington Post الأمريكية، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022.
فيما انتشر مؤخراً مقطع فيديو على نطاق واسع، سُمع فيه صوت امرأة أوكرانية تقول للجنود الروس المسلحين على الأراضي الأوكرانية: “خذوا هذه البذور حتى ينمو عباد الشمس هنا عندما تموت”، حسبما أفادت شبكة BBC البريطانية.
“Take these seeds so sunflowers grow here when you die”
Footage shows Ukrainian woman confronting armed Russian soldier
Follow live coverage on Russia’s invasion of Ukraine: https://t.co/vPdkyzs8cg pic.twitter.com/4Rn56iNYb0
— BBC News (World) (@BBCWorld) February 25, 2022
في حين صُوِّرَت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يوم الإثنين 28 فبراير/شباط الماضي، وهي تضع زهرة عباد الشمس على وجهها.
السيدة الاولى جيل بايدن تضع كمامة عليها زهرة عباد الشمس – الزهرة الوطنية ل #أوكرانيا pic.twitter.com/NQrQe6IxOx
— Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) March 1, 2022
كما ارتدت جيل، الزهرة على فستانها في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء 1 مارس/آذار، فيما أعلن الرئيس بايدن قائلاً: “نحن الولايات المتحدة الأمريكية نقف مع الشعب الأوكراني”.
من جهتها، ارتدت السيناتورة كيرستن غيليبراند (ديمقراطية من ولاية نيويورك)، الثلاثاء، زخارف على شكل زهرة عباد الشمس.
Some artists have been posting their sunflower paintings in honor of Ukraine. The #sunflower is their national flower. Here’s one of mine. 🇺🇦 #istandwithukraine pic.twitter.com/aEXHotb6OP
— Kelly Eddington (@kellyeddington) February 25, 2022
فيما يرسم الفنانون زهور عباد الشمس، وأولئك الذين زاروا أوكرانيا من قبل وحقولها الصفراء اللامتناهية يشاركون صوراً للمشاهد التي التقطوها هناك.
إزالة الأسلحة النووية
يشار إلى أنه في صيف عام 1996، قام مسؤولون بزراعة عباد الشمس في قاعدة بيرفومايسك للصواريخ بجنوب أوكرانيا بمناسبة إزالة الأسلحة النووية من البلاد.
آنذاك قالت صحيفة Washington Post الأمريكية: “احتُفِلَ بتخلِّي أوكرانيا عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها في عام 1991 بانهيار الاتحاد السوفييتي”.
في غضون ذلك، يستخدم الأشخاص والشركات الصغيرة بالمملكة المتحدة منصة “فيسبوك” لمشاركة الطرق التي يدعمون بها أوكرانيا، وأكثر من نصف مليون شخص أُجبِروا على الفرار.
بدورها، شاركت إحدى بائعات الزهور في مدينة “ليدز” البريطانية صوراً لباقات زهور عباد الشمس المرتبة، وحثَّت الناس على شرائها حتى يمكن التبرع بالعائدات للأعمال الخيرية للأوكرانيين.
كذلك، كتب المتجر الذي يحمل اسم Arts and Flowers: “سيتم التبرع بجميع الأموال إلى نداء أزمة أوكرانيا الذي أطلقه الصليب الأحمر البريطاني”.
حيث قالت مالكة المتجر، كريستي كال (51 عاماً)، إنها شعرت بأن عليها المساعدة، مضيفة: “علينا أن نفعل شيئاً. أيُّ شيءٍ أفضل من لا شيء”.
العملية العسكرية الروسية
يشار إلى أن روسيا أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم؛ وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
أوكرانيا الأسلحة الروسية
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تنصيب حكومة “دُمية” (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد “العدوان”.
في المقابل، تقول موسكو إن “العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي”، وحماية الأشخاص “الذين تعرضوا للإبادة الجماعية” من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفتهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.
—————————
يقصفونهم كما لو كانوا سوريين/ رشا عمران
من حسن حظ شعوبنا أو من سوء حظها أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت تناقل تعليقات الصحفيين والمسؤولين الغربيين حول الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أخيرا، فمعظمنا، نحن الذين نعيش في هذه المنطقة من العالم، نستسهل ونتابع أخبار ما يحدث عبر الإعلام العربي، قلة منا من يتابعون الإعلام الغربي ووسائله وهؤلاء يرصدون ما يتم التصريح به وينقلونه لنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولولا هذا لما أتيح لنا أن نقرأ ونسمع خلال الأيام الماضية كيف يرانا الكثير من الغربيين، لا أقصد النظرة إلى السوريين فقط، بل إلى معظم دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية، تحديدا الدول التي شهدت حركة لجوء كبيرة منها إلى دول أوروبا بسبب الحروب أو بسبب الفقر والجوع والاضطهاد الجمعي أو الفردي.
مبدئيا يمكننا القول إن الحروب والخوف منها تظهر أسوأ ما يوجد لدى البشر وفي دواخلهم، هذا ربما يجعلنا نتفهم بعض التصريحات على لسان مسؤولين أوكرانيين، حول استغرابهم أن تقوم روسيا باستهداف شعب يتمتع بمواصفات شكلانية شبيهة بالروس: بشرة بيضاء وعيون ملونة وشعر أشقر! معهم حق حتما ذلك أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يفعل أحد ذلك سوى بوتين نفسه في عام 2014 حين احتلاله شبه جزيرة القرم، وفي ذلك اليوم لم يتم استهداف المدنيين كما يحصل الآن، فمعظم سكان القرم كانوا من الانفصاليين الذين لم يخفوا رغبتهم بالانضمام إلى روسيا، لن تقصف روسيا مواطنين تابعين لها مهما بلغ إجرام نظامها، فبعد الكوراث الإنسانية التي شهدتها أوروبا إثر الحرب العالمية الثانية صار المواطن الأوروبي خطا أحمر بالنسبة لحكوماته، وأدت الاتفاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية إلى ما يشبه الوحدة بين دول أوروبا لاسيما الغربية منها، (دول العالم الأول)، بينما بقيت الدول الشرقية في المرتبة الثانية وتتعرض شعوبها للانتهاكات في السعي للقضاء على كل أثر للاتحاد السوفييتي السابق، لكن معظمها بات يحظى بحماية غربية ستنقذها من طموح قومي وسياسي وعسكري لديكتاتور ما.
(أوكرانيا ليست أفغانستان أو العراق ليتم قصف شعبها هكذا)، هذا أيضا تصريح لمحلل سياسي فرنسي، ربما نسي أن يضيف إليه سوريا بسبب ضيق الوقت المتاح له للكلام، هل أخطأ في قوله رغم جلافة القول وقسوته؟ ما قاله صحيح تماما ففعلا أوكرانيا ليست أفغانستان ولا العراق ولا سوريا، ذلك أن المواطن الأوكراني الأبيض مواطن حقيقي، يتمتع بحقوق كاملة، على المستوى الإنساني والسياسي، ربما يعاني مثل سائر مواطني دول العالم من أزمات اقتصادية وداخلية، لكنه ليس مضطهدا في وطنه، وليس متروكا تحت رحمة أنظمة فاشية ومستبدة فاشلة أصلا وتعوض فشلها بالإجرام والقمع والفساد، وليس مخططا له أن يكون فأر تجارب مصنع السلاح الغربي، وليس مسموحا بأن تكون بلاده مسرحا مفتوحا دائما لعروض القوة والتحالفات والتجاذبات، أوكرانيا ليست العراق التي ترك شعبها عقودا تحت حكم ديكتاتور فاسد ثم احتلتها أميركا وأمعنت فيها تفتيتا حتى لم يبق من العراق العظيم سوى الخراب، وليست أفغانستان التي مازالت منذ الحرب الباردة وحتى اللحظة متروكة مثل لعنة أبدية تختزن كل أنواع الإرهاب، وليست سوريا التي تعاني منذ عشر سنوات من كل أنوع الاحتلالات الداخلية والخارجية، وقصف شعبها بكل أنواع القذائف المسموحة والممنوعة، لم يخطئ المحلل الفرنسي في قوله، مثله مثل محلل سياسي آخر قال: ( أخيرا أوروبا تستقبل لاجئين مثقفين ويمكنها الاستفادة منهم)، لم يخطئ هؤلاء المحللون والصحفيون والسياسيون فيما قالوه، فالحروب كما عاصروها لونها ترابي ورائحتها فقيرة وضحاياها ببشرة غامقة وعيون مكحلة بحزن تاريخي طويل، أما الإنسانية فمدللة، بشرتها بيضاء وشعرها أشقر وعيونها بلون السماء والبحر، أن تتحول الحروب إلى اللون الأبيض فهو خطأ تاريخي يجب الوقوف في وجهه أو محاولة تلطيفه والتخفيف عن ضحاياه.
لست هنا في وارد الدخول في سردية مظلومية ما، لا عربية ولا إسلامية، فأنا من المؤمنات أن ما يحصل لنا صنعناه بأيدينا أو ساهمنا بصنعه بطريقة ما، لكن فعلا وخلال متابعة التعليقات والتحليلات حول الحرب الروسية على أوكرانيا، وجدت نفسي، وكثر مثلي، مواجهة مع رؤية الغرب لنا، نحن العرب والمسلمين، كيف يروننا ولماذا تشكلت هذه النظرة لديهم عن شعوبنا، لماذا يتم التنكيل باللاجئين القادمين من بلادنا على حدود أوروبا بينما يتم الترحيب المبالغ به باللاجئ الأوكراني، ورغم أنه لا يمكن الاستهانة بما قدمته دول اللجوء للهاربين من بلدانهم، لا سيما السوريين، ولكن ألا يحق لنا أن نسأل كيف سمح هذا العالم بأن يحدث ما حدث في بلداننا ولماذا يتم دعم الديكتاتوريات الحاكمة التي تنهك شعوبها بالقمع والفساد والفقر والتجهيل، وتقضي على كل قدراتها وإمكاناتها في التغيير وتستفز كل غرائزها الكامنة، ثم تبدأ مرحلة الاحتلالات بأشكالها المختلفة، كما لو أن قدرنا وقدر شعوبنا الخضوع المستمر لكل أنواع الاستبداد؛ في الوقت نفسه الذي نسأل فيه عن طريقتنا في تقديم أنفسنا للغرب ورؤيتنا له أيضا، حيث يتعامل معظمنا معه بوصفه عدوا كافرا وعلينا واجب الجهاد ضده، ورغم أن كل الحركات الجهادية نشأت في مصنع الغرب أولا لكن لنعترف أنها لاقت قبولا في مجتمعاتنا، وساهمت وسائل التواصل في جعل هذا القبول علنيا، وسنكون واهمين لو ظننا أن ما يكتب على وسائل التواصل لا يتم رصده ومتابعته بدقة من قبل مراكز غربية متخصصة.
(يقصفونهم كما لو أنهم سوريون)، قد تكون الجملة السابقة هي لسان حال الكثير من الغربيين والأوروبيين وهم يرون الجيش الروسي يقصف المدن الأوكرانية ويقتل المدنيين في بيوتهم، فروسيا منذ 2015 تاريخ دخولها إلى الأزمة السورية وهي لا تتوقف عن قصف المدن السورية ولا عن قتل المواطنين السوريين، وتتصرف بسوريا كما لو أنها ولاية تابعة لها، وتتحالف مع إسرائيل على قصف مواقع عسكرية موجودة في سوريا تابعة لإيران، وتتصرف بالاقتصاد السوري كما يحلو لها، يحدث ذلك على مرأى العالم ومسمعه دون أي تدخل منه، فروسيا دولة عظمى ولها حق الفيتو وتربطها بالجميع مصالح اقتصادية سيؤدي التصادم معها إلى خلخلة التوازن الاقتصادي المستقر نسبيا، وسوريا دولة من العالم الثالث على حدود إسرائيل، إنهاكها واستنزافها عسكريا واقتصاديا وبشريا سيكون مفيدا لصالح عملية التطبيع المخطط لها بين إسرائيل ومن تبقى ممن لم يطبع حتى الآن، كما أن الغرب أرضى ضميره واستقبل لاجئين سوريين كثر، لابأس ليفعل القيصر الروسي ما يريده في سوريا، لم يعد شأنها يعني أحدا، لكن أن يفعل ذات القيصر الشيء ذاته في أوكرانيا فهذا أمر لا يمكن التهاون معه، “فأوكرانيا ليست سوريا عزيزنا القيصر، ولن يسمح لك بالتمادي رغم تهديدك بالنووي، لن يتاح لك أن تواصل قصف الأوكرانيين كما لو كانوا سوريين، ستلجأ للتفاوض أو ستكون حربا شاملة مدمرة فما تأسس عليه العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية لن يسمح أن يتم تغييره بالسهولة التي تعتقدها عزيزنا القيصر بوتين”.
تلفزيون سوريا
———————————–
هل ورط الغرب بوتين في حرب استنزاف طويلة الأمد؟/ أسامة محمود آغي
أساس حرب روسيا على أوكرانيا يكمن في الأسباب التالية: أن النظام السياسي الروسي، وهو في جوهره نظام رأسمالي، بُني على أنقاض تفكك الاتحاد السوفييتي، ولا يرغب هذا النظام، أن يتمّ احتواؤه من طرف ما يسمى “نظام العولمة”، الذي تحدث عنه جورج بوش الأب إثر تفكك بلاد السوفييت مطلع تسعينات القرن العشرين.
عدم قبول احتواء روسيا من الغرب، يقف خلفه النزعة القومية الشوفينية الروسية، فهذه النزعة لم تكتمل دورة حياتها، نتيجة قيام نظام أممي على مبادئ غير قومية، وهو أمر أبقى لدى دول الاتحاد السوفييتي السابق فراغاً بنيوياً يجب أن يمتلئ، وهذا يعني ضرورة المرور بالطور القومي، وهو ما تحملته القوى البرجوازية في أي بلد.
القوميون الروس لا يزالون يريدون أن تبدو روسيا على الصعيد العالمي دولة ذات ثقافة قومية محددة، وذات إرث سياسي مركزه موسكو، ولهذا فهم يتخوفون من محاولة ابتلاعهم ضمن ما سماه جورج بوش الأب “العالم قرية واحدة صغيرة”، وهو يقصد وحدة هذا العالم سياسياً ضمن بوتقة العالم الرأسمالي الذي تقوده النيو ليبرالية الأمريكية.
وفق هذه الرؤية، يمكن القول إن روسيا لا يمكنها قبول مجاورة الغرب لحدودها مع أوكرانيا، وهو إحساس خوف لدى القوميين الروس المتشددين، الذين يتقدمهم قيصرهم بوتين، ولهذا خططت القيادة البوتينية لغزو أوكرانيا الغنية بثرواتها، والمحكومة بحكومة ديمقراطية، من أجل منع اقتراب حلف الناتو من أراضيها، وبنفس الوقت تحقيق دولتها القومية ذات الاتجاه الإمبراطوري الجديد، والذي يمثله التدخل الروسي في كثير من بلدان بعيدة عن الجغرافية الروسية، مثل تدخلهم في سوريا وليبيا وغيرهما من البلدان.
إذاً، نحن أمام تصميم روسي بحسابات خاصة، تقوم على تداخل الفهم الشوفيني لبنية الدولة الروسية، وطموحها نحو تشكيل قطب سياسي وعسكري عالمي.
ولكن، هل يمكن تحقيق عملية احتواء الروس لأوكرانيا بمثل هذه الحرب السريعة؟ وهل حسب بوتين نتائج هذه الحرب على بنية دولته ومشروعاتها الخارجية وعلى اقتصادها؟ أم أن حساباته تقوم على نظرية تحقيق أكبر قدر من الهزيمة بالعدو الأوكراني في أقل مدة زمنية، يستطيع من خلالها وضع أوراق تفاوض قوية على طاولة التفاوض مع الغرب؟
يعتمد بوتين على هذه الرؤية المدججة بالتهديد باستخدام القوة النووية، وهذا ظهر مع استنفار أقصى لقواته النووية مع شن هجماته على أوكرانيا.
لكن حسابات الغرب، وفي مقدمته حكومة بايدن الديمقراطية، لا تقوم على قاعدة مواجهة عسكرية مباشرة مع الروس، لسبب بسيط، وهو خشيتهم من انزلاق المواجهة المباشرة بين الجيش الروسي والتحالف الغربي إلى حرب عالمية ثالثة، قد تؤدي إلى تدمير متبادل وخطير بين الطرفين.
إن القول إن الغرب ترك أوكرانيا منفردة بمواجهة غزو روسي مخيف هو قول خاطئ، لأن ما ظهر من الغرب بعد خمسة أيام من شن الروس لهذه الحرب، يُظهر أن الغرب يعتمد لمواجهة الغزو الروسي على أمرين اثنين، الأول هو استخدام عقوبات اقتصادية ومالية ذات تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمالي الروسي، وهو أساساً يبدو شديد الهشاشة، والثاني هو حرب استنزاف للقوات الروسية، عبر السماح بتدفق المقاتلين من أوروبا والخارج لمقاومة هذا الغزو، وجعله يدفع فاتورة باهظة لا تحتملها روسيا. وقد ظهر ذلك من خلال السماح بتدفق الأسلحة أمريكياً وألمانياً وأوربياً لصالح مقاومة الغزو الروسي.
لقد أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة حول الموقف الأمريكي من الحرب على أوكرانيا، “أن 72% من الأمريكيين قالوا إن بلادهم يجب أن تلعب دوراً محدوداً في الصراع الروسي الأوكراني، أو لا تتدخل مطلقاً بهذا الصراع”. هذا الاستطلاع الذي أجراه مركز AP- NORC، يكشف عن خلفية موقف حكومة بايدن الديمقراطية، التي تركّز على عدم الانخراط في الحروب، وكذلك على الانسحاب من وجودها في مناطق عديدة من العالم.
لقد قال الرئيس الأمريكي بايدن لشبكة إن بي سي حرفياً: “ليس الأمر وكأننا نتعامل مع منظمة إرهابية، نحن نتعامل مع واحدٍ من أكبر الجيوش في العالم، وهذا وضع صعب للغاية، ويمكن أن تسوء الأمور بسرعة جنونية”.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المجموعة الأوروبية، تعرف أن نجاح بوتين في الاستيلاء على أوكرانيا سيغيّر من واقع التوازن الأمني والعسكري بينهم والروس، وهذا سينعكس بالضرورة على بنية النظام العالمي القائم الآن، والذي تشكّل فيه الولايات المتحدة القطب الأكبر والأقوى على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية على المستوى العالمي.
وكي لا يقع هذا المحظور، يمكن تشتيت الهجوم الروسي والقوة الروسية في أكثر من ساحة صراع بينهم، وهذا يستدعي تحفيز ساحات الصراع الأخرى ضد الروس، مثل الساحة السورية والساحة الليبية وغيرهما من الساحات، وهذا يعني حرب استنزاف لروسيا اقتصادياً وعسكرياً، في وقت هي لا تحتمل هكذا استنزاف.
مثل هذه الرؤية كشفت عنها تسريبات تقول: أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقلب الطاولة على الروس في سوريا من خلال فرض منطقة حظر طيران فوق إدلب وباقي الشمال السوري، فإذا صحّت التسريبات ستتغيّر المعادلات العسكرية والأمنية لغير مصلحة الروس في سوريا وفي أوكرانيا وربما في ليبيا أيضاً.
إن تغيير استراتيجية التعامل مع الانتشار الروسي خارج الأراضي الروسية ينبغي أن يحدث في سياسات الولايات المتحدة والغرب، وهذا يتطلب سياسة مختلفة، تعتمد على تشتيت قوة الفعل العسكري والسياسي الروسي في ساحات تدخلهم الخارجية، ولعل الروس يدركون تماماً، أن تركيا التي زوّدت أوكرانيا بالمسيرات المتطورة (بيرقدار)، إنما كانت رسالة لهم لتغيير سياستهم حول محاولتهم تدوير نظام الاستبداد الأسدي، وإفهامهم أن حدوداً لا يمكنهم تجاوزها في محاولة فرض الأمر الواقع في سوريا، وفي أوكرانيا أيضاً.
وفق ما تقدم يمكننا الاستنتاج، أن الروس القوميين المتشددين يحسّون بالخطر الوجودي فيما يتعلق بقدرتهم على بناء مشروعهم القومي الشوفيني، المهيمن على شعوبٍ، كانت ذات يوم جزءاّ من منظومة الاتحاد السوفييتي البائد، هذا الخطر، لن يستطيعوا مواجهته لسببٍ بسيطٍ، وهو أن مشروعهم لا يصلح لمواجهةٍ مع نظام عالمي، لم تكتمل فصول بنائه بعد.
كذلك إن كلفة مواجهة العولمة سيتمّ دفع قيمتها من حياة الشعب الروسي، الذي لم يتحرر من استبداد الأنظمة الشمولية، والذي يتوق إلى الالتحاق بعربات التطور التاريخي للنظام السياسي العالمي.
لهذا، فإن غزو أوكرانيا، قد يشكّل بداية لانحلال الاتجاه القومي الشوفيني، الذي تمثّله حكومة بوتين، وهو ما يقرّب ساعة نهايتها السياسية.
TRT عربي
باحث واعلامي سوري
————————-
===================
تحديث 03 أذار 2022
————————–
الصراع على أوكرانيا ومستقبل النظام الدولي/ علي العبدالله
تمر أوكرانيا بمرحلة دقيقة وخطيرة بعد أن غدت ساحة لصراع إرادات داخلية، وميداناً لتنافس دولي لتوضيح الأحجام والأوزان وتكريس معادلة جديدة والتموضع فيها عبر عملية عض أصابع بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء حالة الفتور في العلاقات على خلفية التضارب في التعاطي بين ميل الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، لضبط العلاقات المتغيرات الإقليمية والدولية، ونزعة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القومية، ورغبته الواضحة في إعادة تشكيل الفضاء الخارجي وشغل روسيا موقع الاتحاد السوفييتي عبر فرض الهيمنة الروسية على البلدان التي كانت تدور في الفلك السوفييتي وتلك التي ربطتها به علاقات قديمة في الشرق الأوسط؛ وتغيير النظام الدولي بحيث تكون روسيا قطبا دوليا معترفا به.
تشابك وتمايز تاريخي
ظهرت أوكرانيا كدولة مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 تعبيراً عن نزوع قومي صاعد بين الأوكرانيين، الذين عبروا ليس عن تميزهم عن الروس فقط، بل وعن ميلهم للالتحاق بالغرب. فرغم العلاقات التاريخية العميقة مع روسيا: ولادة الأمة الروسية والكنيسة الأرثوذوكسية، التي غدت الكنيسة القومية الروسية بعد اعتناق الأخيرة للمسيحية، في أوكرانيا، تقول الأسطورة الروسية: «تم تعميد الأمير فلاديمير عام 988 قرب ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم؛ في أولى خطوات دخول المسيحية لهذه البلاد». وقد مثّل استيلاء الروس على شبه جزيرة القرم من العثمانيين عام 1773 تطوراً كبيراً في مصائر روسيا، التي أصبح لها للمرة الأولى ميناء في المياه الدافئة، وأسطولاً قرب البحر الأبيض المتوسط.
وضع الترابط العضوي الذي ترسخ على مدى قرون بين روسيا وأوكرانيا الثانية على رأس قائمة أولويات الأولى. فقد ظلت العلاقات بين البلدين أشبه بعلاقات بلد واحد تفصل أطرافه حدوداً وحواجز وقوانين محلية، فقرابة نصف سكان الأقاليم الشرقية يتكلمون اللغة الروسية ويتطلعون إلى تعزيز التقارب مع موسكو، وهذا لعب دوراً رئيساً في تحويل أوكرانيا إلى ساحة نفوذ أساسية للروس، ونافذة حيوية لهم على أوروبا لا يمكن فصلها من دون إلحاق أضرار كبيرة بروسيا نفسها. لذا كانت روسيا، ومازالت، حريصة على تعزيز هذا النفوذ، وبناء علاقة سياسية مستقرة ودائمة معها، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو ضمن إطار الاتحاد الأوراسي، الذي تصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تكون أوكرانيا حجر الزاوية فيه. بدون أوكرانيا، يفقد الاتحاد الأوراسي معناه كلية، بسبب أهميتها الجيوستراتيجية، باعتبارها الممر السهلي لروسيا باتجاه أوروبا الغربية. وقد سبق أن قال مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة الرئيس جيمي كارتر 1977- 1981، زبيغينيو بريجنسكي: «دون أوكرانيا لن تكون روسيا دولة عظمى». فأوكرانيا تقع في نطاق دبلوماسية «الجوار القريب» التي اعتمدتها روسيا منذ عهد القياصرة. وقد اتخذت، الدبلوماسية، بعد الحرب العالمية الثانية، شكلين ظاهرين؛ إما بسط هيمنة موسكو بـ «الواسطة» على دول «الجوار القريب» – كما كان الحال مع أوكرانيا؛ وما هو عليه حالياً مع طاجيكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في منطقة القوقاز- أو تحييدها قسراً ومنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما هو الحال مع فنلندا وبيلاروسيا.
تغيرت معادلة القوة بين روسيا وأوكرانيا بفعل التحول والتغير الذي طرأ على روسيا وتوسعها على حساب دول الجوار، ولكن العلاقة بينهما ظلت متينة، فقد غدا لروسيا نفوذ كبير فيها، سواء على مستوى الأشخاص النافذين أو على مستوى المؤسسات. ولكن قاعدتها الأكثر وثوقاً وقوة تمثلت في الأقلية الروسية، التي تصل نسبتها إلى 17.3 في المئة من السكان، وتتمركز في شبه جزيرة القرم والأقاليم الشرقية المحاذية لروسيا، ففي هذه الأخيرة على وجه الخصوص، لا تتحدث أغلبية السكان اللغة الروسية وحسب، بل إن صلات السكان التجارية، الصناعية، العائلية، بروسيا عبر الحدود، تمتد إلى عقود طويلة، وربما إلى قرون.
احتلت أوكرانيا، بسبب موقعها وعدد سكانها،46 مليون نسمة، موقعاً هاماً في اتحاد الجمهوريات السوفييتية. استمرت التجربة السياسية المشتركة حوالى ستين سنة، إلا أنها كانت السباقة للمطالبة بالخروج منه بُعيد توقيع الرئيسين الأميركي، رونالد ريغان، والسوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، على إنهاء الحرب الباردة عام 1989، في ظل عودة إلى نزوع قومي أوكراني بقي كامناً حتى واتته الفرصة للصدع بالموقف. وقد اقترنت نزعة الاستقلال بميل للتوجه غرباً والالتحام بالاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات الثنائية والجماعية مع دوله، في بعث لتاريخ أوكراني عريق، فثلاثة أرباع الشعب الأوكراني يتمسكون بالثقافة الغربية، ويشعرون بالولاء لأوروبا الوسطى، حيث كانوا عبر التاريخ جزءاً من إمبراطورية أسرة هابسبورغ التي حكمت أجزاء كبيرة من أوروبا واستمر عهدها بين عامي 1438 و 1740 وكانت تضم ليتوانيا وبولندا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى. ويتطلع هؤلاء الأوكرانيون إلى أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي حتى يتمتعوا بمزايا الثروة والنجاح الاقتصادي، ويرغبون في الانضمام إلى حلف الناتو ليصبحوا حلفاء للولايات المتحدة. وقد فعلوا مثل هذا في الماضي بين الحربين العالميتين، وحاربوا في سبيل صيانة استقلال بلدهم. وتطلب غزو أوكرانيا من قبل البلاشفة الشيوعيين عام 1932 حرباً دامت 10 سنوات. وما لبث النظام البلشفي في موسكو أن فرض مجاعة ممنهجة عليهم بعد أن نهب محاصيلهم الزراعية وطبق عليهم قوانين جائرة لإجبارهم على ترسيخ التصنيع في المناطق الشرقية وحدها، ما أدى إلى موت سبعة ملايين أوكراني. ولا يمكن لأي أوكراني أن ينسى هذه المأساة المروّعة.
خلفية الصراع الغربي الروسي
مع نهاية الحرب الباردة (قمة مالطا بين الرئيسين بوش الأب وغورباتشوف عام 1989) وانهيار الاتحاد السوفييتي (1991)، شهد العالم توجهاً سياسياً دعا إلى تصفية بؤر التوتر والحروب وإقرار السلم العالمي. فقد سادت، لفترة وجيزة، أدبيات البيروسترويكا التي بشّر بها آخر رئيس سوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، والتي تدعو إلى إقامة نظام دولي يعتمد «توازن المصالح» قاعدة له، وتعطي الأولوية للتعاون الدولي، ما يعني تراجع العامل العسكري وإعطاء الصدارة في العلاقات الدولية للعاملين السياسي والاقتصادي. وقد قاد هذا المناخ إلى بروز دعوات أوروبية لحل حلف الناتو بعد أن غدا، بفعل نهاية الحرب الباردة وحل حلف وارسو وانهيار الاتحاد السوفياتي، بلا معنى أو هدف، وإلى قبول دعوة غورباتشوف لإقامة أوروبا واحدة من الأورال إلى الأطلسي، وإلى حل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، وتقديم يد المساعدة للدول الفقيرة لإخراجها من حالة الانهيار الاقتصادي والصراعات العرقية والسياسية.
رفضت الولايات المتحدة هذا التوجه وقاومته بقوة، فالمحافظة على «توازن القوى» قاعدةً للعلاقات الدولية، وعلى حلف الناتو وتوسيعه وتعديل استراتيجيته وساحة عمله، مصلحة أميركية. لذا تبنت سياسات مراوغة ودفعت باتجاه تأزيم النزاعات، ودفع أطرافها إلى اعتماد الخيار العسكري، ولعل ما حدث في يوغسلافيا آنذاك خير مثال على هذا السلوك، حيث كشفت صحيفة هيرالد تريبيون (15 و 16 أيار/ مايو 1995) ما قاله جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية، عام 1990 للرئيس اليوغسلافي، سلوفودان ميلوزوفيتش، «إن واشنطن مع يوغسلافيا موحدة أرضاً وشعباً»، وهذا شجع الأخير على الاندفاع في حرب مجنونة دمرت بلاده وشعبه وقادته إلى محكمة جرائم الحرب (يذكرنا هذا بلقاء السفيرة الأميركية، أبريل غلاسبي، مع الرئيس العراقي، صدام حسين، قبل اجتياح الكويت، وإعلان ريتشارد أرميتاج، مساعد وزير الخارجية الأميركية، في دمشق عام 2004 أن قضية التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود قضية تحل بالتفاهم بين سورية ولبنان).
وقد عملت الولايات المتحدة في القمة الخمسينية للحلف في واشنطن عام 1999 على إلزام الحلفاء بتنفيذ مقرراته، والتي تبنت تحويل الحلف إلى مرجعية لقرار الحرب والسلم في العالم. انطلق الولايات المتحدة من تصور مبني على ضرورة الوجود العسكري المباشر في عدد من الأقاليم حول العالم، ولاسيما الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومحيط البحر الأسود، بهدف السيطرة على التفاعلات الإقليمية السياسية والاقتصادية والتحكم بالخريطة الجيوسياسية في هذه الأقاليم، ما جعل هدف توسيع حلف الناتو يحتل موقعاً مركزياً في هذه الخطة.
لم يستمر حلف الناتو ويوسع ساحة عمله فقط، بل واندفع بتوسيع عضويته بضم دول أوروبا الشرقية، حيث ضم أحد عشر بلداً من بلدان أوروبا الشرقية، بما فيها بولندا وبلدان البلطيق الثلاثة: لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وطرح انضمام أوكرانيا إليه، بالإضافة إلى دول أخرى محاذية لروسيا مثل أرمينيا، والاقتراب من الحدود الروسية أكثر فأكثر، مستغلاً ضعف روسيا وارتباكها ودخولها في حالة انعدام وزن خلال فترة حكم بوريس يلتسين. وقد جاء نشر أجزاء من الدرع الصاروخي في تشيكيا ورومانيا وتركيا، وأجزاء أخرى متحركة على ظهر ناقلات في دول البلطيق ليثير مخاوف روسيا، لأنه يمنح الولايات المتحدة فرصة توجيه الضربة الأولى ويشل قدرة روسيا على الرد. ففي ذهن الروس مقولة وزير الخارجية الأميركية الأسبق، هنري كيسنجر، «روسيا مازالت كبيرة لذا فهي خطيرة».
تحفظت روسيا على عمليات التوسع لجهة تعارضها مع التفاهم الذي تم بين الغرب والاتحاد السوفييتي خلال مفاوضات توحيد ألمانيا. لكن موسكو، مع التصريحات الرسمية الروسية الحادة التي ترفض توسع الحلف، رضخت ووقّعت مع الحلف عام 1997، في عهد الرئيس يلتسين، «ميثاق باريس» الذي فتح الباب أمام انضمام بولندا وتشيكيا والمجر إلى صفوف الحلف كدفعة أولى. وبعد ذلك، وفي عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التوقيع على «إعلان روما» عام 2002، الذي جرى بموجبه تأسيس مجلس روسياـ الناتو ومواصلة الحلف ضم المزيد من دول شرق أوروبا. كان مهندس الحرب الباردة جورج كينان وصاحب نظرية الاحتواء قد أعلن عام 1999 أنه يعارض فكرة توسّع حلف الناتو نحو الشرق، وأخبر زميله توماس فريدمان حينئذ بأن التوسع باتجاه الشرق سيكون «خطأً مأساوياً» لأن العدو في ذلك الوقت لم يكن روسيا، بل الحزب الشيوعي السوفياتي. ولم يكن من الضروري حسب كينان توسيع حلف الناتو، لأن ذلك سوف يجبر روسيا على العودة للعب دورها باعتبارها الطرف المعادي للغرب، وقد تسعى لإشعال أوار حرب باردة جديدة. وبالإضافة لكل هذا «ليست لدينا نيّة للذهاب إلى الحرب بسبب تلك البلدان النائية».
لقد استسلم القادة الروس لعمليات التوسع، حتى أن بوتين عندما وصل إلى السلطة تحدث عن احتمال انضمام روسيا ذاتها إلى الحلف.
تبنت روسيا خلال رئاسة بوتين الثالثة، مدفوعة بنزوع قومي روسي لإعادة الاعتبار لروسيا والثأر من مرحلة الضعف والاحتقار الغربي، رؤية قائمة على قوة الدولة وضمان ولاء الكنيسة الأرثوذكسية والتمسك بالقيم الثقافية العريقة، تبنت استراتيجية هجومية بهدف فرض هيبتها ودورها الإقليمي والدولي، وعملت على تعزيز الوجود العسكري الروسي في الساحة السوفيتية السابقة من خلال قواعد عسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرمينيا، ومن خلال تقوية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم حالياً ست دول، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأرمينيا، ودعت إلى تشكيل اتحاد جمركي يضم دول الاتحاد السوفياتي السابق تحت اسم الاتحاد الأوراسي، كإطار موازٍ ومنافس للاتحاد الأوروبي، يمثل برأيها عالماً بديلاً قائما على رفض القيم الغربية، ومبني على تصور لا يسمح لأية دولة فيه أن تصوغ سياساتها وتحدد أطر مستقبلها بشكل منفرد، ويقع تحت السيطرة الروسية الكاملة. وأطلقت، مستفيدة من تحسن سعر النفط والغاز الذي مكنها من تجاوز حالة العجز التجاري والمالي وحولها إلى وضع إيجابي مع احتياطي نقدي كبير سمح برفع الموازنة العسكرية، برامج اقتصادية وعسكرية لإعادة التوازن لوضعها الداخلي وزيادة قدرتها على التحرك الإقليمي والدولي. وهذا أجج هذا الخلافات مع الغرب بعامة والولايات المتحدة بخاصة. وقد جاءت تحولات الربيع العربي والتصرف الغربي في ليبيا، وانفجار الثورة السورية، على الضد من هوى الكرملين لتزيد في سخونة المواجهة، في ضوء خشية موسكو فقدان آخر معاقلها في المتوسط، فتبنى الكرملين موقفاً منحازاً للنظام السوري في محاولة لتحقيق هدفين، الأول حماية مصالحه ووجوده في المتوسط (قاعدة طرطوس)، والثاني الانتقام من حرمان روسيا من الكعكة الليبية.
تزامن هذا التحرك مع إدارة أميركية تبنّت، لاعتبارات داخلية (الرفض الشعبي للحروب الخارجية بسبب الضحايا والتكلفة المالية العالية، حيث قدر اجمالي خسائر الحرب في أفغانستان والعراق بـ 8 تريليون، خلل مالي، مشكلات اقتصادية: بطالة تضخم، تآكل البنى التحتية)، خيارات الحد من التدخل الخارجي، والتعاون والعمل المشترك لمواجهة المشكلات والعمل على تحقيق المصالح بطرق أقل تكلفة بشرياً ومادياً، ما منح التحرك الروسي فرصة تسجيل نقاط تفّوق ظاهرية عززت اندفاعة بوتين ورفعت من أسهمه الداخلية والدولية، ودفعته إلى الرفع من نبرة التحدي والتوسع في عرض العضلات واستخدام القوة ضد خصومه الداخليين والخارجيين. وقد أغرى غياب الرد المباشر بوتين على العمل لتحقيق نصر على الغرب في سورية عبر دعم النظام السوري بأسباب البقاء، وتغطيته إعلامياً ودبلوماسيا وحمايته سياسياً.
ردت واشنطن على التشدد الروسي في سورية وإفشاله لـ جنيف2، عبر عدم قيامه بالدور المطلوب والضغط على النظام لدفعه للانخراط في مفاوضات جادة، بتشجيع المعارضة الأوكرانية وإشعال حريق في الحديقة الخلفية لروسيا.
تحركت موسكو ضد التظاهرات الأوكرانية والبرلمانية وهروب حليفها الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، بالتدخل غير المعلن في شبه جزيرة القرم وتشجيع الروس هناك للمطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وتنفيذ الخطوة وضم الجزيرة إلى روسيا تحت ذريعة نتائج الاستفتاء. جاء رد الفعل الروسي في شبه جزيرة القرم، مع توجه للّعب بورقة حماية الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا، للضغط على كييف للعودة إلى الاتفاق الذي تم بين يانوكوفيتش والمعارضة برعاية دول غربية، وإلغاء كل الخطوات التي أخذها قادة الانقلاب عليه، وعلى الغرب، للتخلي عن مساعيه ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. فموسكو لم تكن بعيدة عن الصواب عندما قدرت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي أن مشكلتها الكبرى هي في الخارج القريب، ومحاولتها تأمينه، إلا أنها وُوجِهت بتقدم استراتيجي غربي حثيث، حُمل في أغلب الحالات على موجة تحول ديمقراطي وأحلام الانضواء في الوحدة الأوروبية، فلم تجد سوى تصعيد الروح القومية الروسية مرتكزاً لمقاومة هذا التقدم الغربي.
راهنت روسيا على أن يشكل ضم شبه جزيرة القرم خطوة في لعبة دومينو وتحرك سكان الأقاليم الشرقية للمطالبة بالانضمام إلى روسيا، اعتماداً على أن نحو 17,3 في المئة من سكانها هم من الروس، وأن 43 ـ 46 في المئة من السكان يتحدثون الروسية، يعيشون في شرقها، بجوار الحدود الروسية، حيث يسهل دعمهم، وحيث تتركز فيه الموارد والثروات والطاقات الإنتاجية بما يساهم بأكثر من 70 في المئة في الناتج القومي الأوكراني، وحرمان أوكرانيا من هذه الموارد. رأى خبراء روس أن انضمام جزيرة القرم قد يفتح شهية أقاليم ومناطق أخرى في الساحة السوفييتية السابقة لطلب الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وأبرزت وسائل إعلام روسية أن إقليم بريدنيستروفييه بجمهورية مولدافيا السوفياتية السابقة، حيث يشكل الروس نحو 30 في المئة من سكانه، يطالب هو الآخر بالانضمام إلى روسيا. مع عدم استبعاد احتمال تزايد مثل هذه الطلبات في الفترة المقبلة، خاصة إذا علمنا أن عدد الروس الذين وجدوا أنفسهم خارج روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، ليس بالقليل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكل الروس في كازاخستان بين 23 و 30 في المئة من سكانها، وفي لاتفيا نحو 29 في المئة، وفي إستونيا نحو 25,5 في المئة. يدور الحديث هنا عن السكان من أصول روسية فقط، وإذا أضفنا إليهم عدد السكان الناطقين بالروسية تصبح الصورة أكثر تعقيداً.
لم يقف الوضع عند هذا الحد، حيث صعّدت روسيا الموقف في أوكرانيا عبر تشجيع ودعم الروس والناطقين بالروسية في منطقة الدونباس على إعلان التمرد على السلطة المركزية والمطالبة بحكم ذاتي يسمح لروسيا عبره بالتأثير على قرارات كييف. وقد ترتب على هذه الخطوة إعلان قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين هما لوغانسك ودونيتسك يوم 12/5/2014 بعد استفتاء شعبي.
اعتبر الغرب ما تم في شبه جزيرة القرم خرقاً للقانون الدولي، ورأى فيه فرصة لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ورسم الحدود الشرقية للاتحاد وإبعاد روسيا عن دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا. لم يثر ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا حفيظة الدول الغربية فقط، بل ودول على علاقة جيدة بروسيا: الصين، بيلاروسيا، كازاخستان، ودول أخرى من دول الاتحاد السوفياتي، كلٌ لاعتباراته الخاصة. فقد تبنت الصين موقفاً «محايداً» فهي لا ترغب في خوض معارك الآخرين لاعتبارات كثيرة، منها الأوضاع في التبت وتايوان. وفي الوقت نفسه، لا ترغب الصين في خسارة روسيا نتيجة احتياجها المتزايد لموارد الطاقة من أجل مواصلة نموّها الاقتصادي. وقد تخوفت بيلاروسيا وكازاخستان من قيام روسيا بذلك معها مستقبلا.
اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الرد الذي ستأخذانه ضد التحرك الروسي في أوكرانيا: دعم أوكرانيا اقتصادياً ومعاقبة روسيا، وهذا ما عكسته المباحثات الأوروبية الأوكرانية والاتفاق على تقديم قروض مالية عاجلة وتفعيل المباحثات حول الشراكة التجارية بين الطرفين، والتصريحات الغربية والإنذار الذي وُجه إلى موسكو بمعاقبتها اقتصادياً وعزلها دبلوماسياً. وقد وضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصوراً للوضع في أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة، وبدأ العمل على تطبيقه عملياً على الأرض بصدور رزمة العقوبات التي اتخذت ضد شخصيات روسية وأوكرانية موالية، وضد بعض المصارف والشركات الروسية.
ناقش قادة الناتو هذه التغيرات بروحية هجومية، ووُضعت تصورات لمواجهتها عبر تشكيل قوة تدخل سريع، وصفها أمين عام حلف الناتو السابق، أندرس فوغ راسموسن، برأس الحربة، تكون جاهزة للتحرك، وفق مقتضى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك للحلف، لنجدة أية دولة من دول الحلف تتعرض لاعتداء خارجي خلال أيام، وإقامة قواعد شبه ثابتة في دول شرق أوروبا (خمس قواعد عسكرية في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ورومانيا وبولندا) ونشر نحو 4000 عسكري فيها، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا عسكرياً ورفع كفاءة جيشها، ومواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا وفرض عقوبات اقتصادية جديدة.
1095px-president_ronald_reagan_and_soviet_general_secretary_mikhail_gorbachev_meet_at_hofdi_house_during_the_reykjavik_summit_iceland.jpg
رونالد ريغان وميخائيل غورباتشيف في قمة ريكيافيك عام 1986 (ويكيميديا)
أدرك الكرملين مدى خطورة خطة الحلف لتكبير قوة التدخل السريع على الأمن القومي الروسي، ومحاولات محاصرة روسيا وتطويقها بقواعد عسكرية للحلف لتغيير الوضع الجيوسياسي لها وحولها، ومواصلة واشنطن العمل على نشر الدرع الصاروخية في دول شرق أوروبا، ما دفعه إلى الإعلان عن تعديل في العقيدة العسكرية أساسه إعادة تأكيد رفض توسع الحلف في اتجاه الحدود الروسية، وزيادة وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، ورفض نشر الدرع الصاروخية، وحق روسيا في استخدام درعها النووية، والتلويح بالانسحاب من معاهدة عام 1987 حول الصواريخ النووية المتوسطة، ورفض انضمام أوكرانيا إلى الحلف، واعتماد سياسة إحلال الواردات في المجالين العسكري والمدني، ما يعني زيادة النفقات العسكرية بأكثر مما هو مخطط له، لموازنة النفقات العسكرية لحلف الناتو والولايات المتحدة الأميركية.
تصعيد التوتر لفرض المطالب
أثار التحرك العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وإعلان انفصال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا مخاوف دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا، ما دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تحريك بعض وحداته العسكرية ونشرها في هذه الدول وإرسال طائرات استطلاع وقطع بحرية إلى البحر الأسود لإجراء مناورات عسكرية مع دول الحلف هناك، دون أن يعني ذلك وجود قرار برد عسكري على التحرك الروسي.
اختلفت تقديرات المحللين حول الخطوة الروسية القادمة، وقد توقّع بعضهم أن يؤدي العناد والخوف في أوكرانيا والدول المجاورة، نتيجة تحركات روسيا العسكرية، إلى إثارة تحركات وأنشطة مضادة من شأنها تقويض الأمن الروسي. وتكهن خبراء روس بتصعيد بين روسيا والغرب خلال الفترة القادمة، فالمشهد الجيوسياسي الراهن يشير إلى أن أوكرانيا أهم بكثير من جورجيا بالنسبة لروسيا، وأبدوا اعتقادهم أن الحرب الروسية ـ الجورجية في العام 2008، ستبدو وكأنها «لعبة صغيرة» بالمقارنة مع ما سيجري بسبب أوكرانيا. وربما يجري اللعب على ورقة تقسيم أوكرانيا إلى غرب وشرق.
غير أن تقسيم أوكرانيا أو الدخول في حرب يمثلان في نظر محللين آخرين خطورة على الجميع، وقد يُفجران نزعات انفصالية داخل أوروبا وروسيا مجدداً. ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد «مفاجآت»، وإن فصلتنا سنوات وتجارب طوال عن حرب القرم، الحرب الشرقية، ما بين عامي 1853 و 1856.
وقد توقّع محللون سياسيون أن يحدث تغير رئيس على الجانب الغربي، ألا وهو عودة الولايات المتحدة للعب دور مركزي في رد الفعل الغربي على التحرك الروسي في ضوء تبدّل الموقف من روسيا بقيادة بوتين، إذ لم تعد الشريك المحتمل للغرب، كما كانت عليه بعد انتهاء الحرب الباردة. لقد تغيرت الظروف التي قادت إلى ابتعاد الولايات المتحدة عن أوروبا وتقليلها من أهمية حلف الناتو، وبذل المزيد من الجهود لتطوير قدرات الحلف من الناحية العسكرية وتهيئته أكثر لمواجهة التحديات الاستراتيجية.
لقد تعددت تقديرات المحللين والمسؤولين الأميركيين حول الرد والمخرج، حيث دعا وزير الخارجية الأميركية الأسبق، هنري كيسنجر، إلى تحول أوكرانيا إلى جسر بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا أن تكون مخفراً أمامياً لأي من الطرفين، وطرح رؤية للحل من النقاط التالية:
1- يجب أن يكون لأوكرانيا حق اختيار ارتباطاتها السياسية والاقتصادية بحرية، بما في ذلك مع أوروبا.
2- يجب ألا تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
3- يجب أن تكون لأوكرانيا الحرية في تشكيل أية حكومة متوافقة مع الإرادة التي يعبر عنها شعبها، ومن ثم سيختار الزعماء الأوكرانيون المحنكون سياسة المصالحة بين الفرقاء المختلفين في الدولة.
4- لا يتوافق ضم روسيا لشبه جزيرة القرم مع قواعد النظام العالمي القائم، لكن يجب أن يكون من الممكن وضع علاقة شبه جزيرة القرم بأوكرانيا في بيئة غير مشحونة، وعلى أوكرانيا أن تعزز الحكم الذاتي لشبه الجزيرة في انتخابات تعقد بحضور مراقبين دوليين، على أن تشمل هذه العملية إزالة أيّ غموض بشأن وضع أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.
ودعا نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون أوروبا والناتو من 2001– 2005، ايان بريزنسكي، إلى اتخاذ الولايات المتحدة والناتو تدابير دفاعية حذرة لتعزيز الأمن في أوكرانيا وهي:
أولاً: ينبغي على الولايات المتحدة أن توافق على الفور على طلب رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني بيتروفيتش ياتسينيوك، بالحصول على معدات عسكرية، من بينها الأسلحة المضادة للدبابات ومضادات للطائرات. هذه المعدات والأسلحة يمكن أن تنقل بسرعة من مخازن الجيش الأميركي الموجودة في أوروبا.
ثانياً: نشر قدرات الاستخبارات والمراقبة والمدربين العسكريين في أوكرانيا. وهذا من شأنه توفير الوعي ومساعدة الجيش الأوكراني في تعزيز قدراته الدفاعية، وسيجبر موسكو في الوقت ذاته على دراسة التداعيات السياسية والعسكرية المحتملة لأي إجراء يؤثر في هذا الوجود.
ثالثاً: يتعين على حلفاء الناتو والشركاء إجراء تدريبات عسكرية خلال الفترة المقبلة في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتدريب الجيش الأوكراني.
وبينما دعا أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ماكين عن ولايات أريزونا، وجون باروسو عن ولاية وايمنج، وجون هوفن عن نورث داكوتا، ورون جونسون عن ويسكونسن، في مقال مشترك إلى «استجابة استراتيجية» لتحدي بوتين بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كبرى البنوك الروسية، وشركات الطاقة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية في روسيا، مثل صناعة السلاح، والتي تعتبر بمثابة أدوات لسياسة بوتين الخارجية. «كما يجب علينا أيضا فضح أفظع قضايا الفساد للمسؤولين الروس وقطع علاقة هؤلاء الأشخاص، وشركائهم في العمل وأقاربهم، باقتصادات الدول الغربية، وكذلك منعهم من السفر إليها»، و«إعادة الناتو التزامه بتنفيذ مهامه الأساسية من الردع والدفاع الجماعي». كما يجب «تعزيز قدرات الناتو العسكرية وتوزيعها بالتساوي بين دول الحلف، بما في ذلك تعزيز وجودها القوي والثابت في وسط أوروبا ودول البلطيق». وهذا يتطلب «عودة الولايات المتحدة عن قرارها تخفيض موازنة الدفاع، وعلى أوروبا تخصيص 2 في المئة من ناتجها القومي لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية للطاقة عبر الأطلسي تقوم على نقل الغاز الأميركي المسال إلى أوروبا لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي». وهذا يستدعي من الدول الأوروبية الاستثمار في إعداد البنية التحتية حتى تتمكن من استقبال الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأخيراً، «يجب على الغرب تقديم المزيد من الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، ومولدوفا وجورجيا وغيرها من الدول الأوروبية التي تطمح في أن تكون جزءا من مجتمعنا عبر الأطلسي». ومن ناحية أخرى، «يجب أن نؤكد لهذه الدول أنها، طالما بإمكانها تلبية معايير العضوية بالطريقة الصحيحة، فإن أبواب الحصول على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي ستظل مفتوحة، وأن هذه الدول ستكون بوسعها القيام بالخيارات الأساسية فيما يتعلق بمستقبل سياستها الخارجية – وليس أي طرف آخر».
فالخيارات المطروحة لمستقبل أوكرانيا عديدة وشديدة التباين:
1- الفدرالية: تطالب بها روسيا، وهذه تعطي الأقاليم صلاحيات واسعة لتحديد علاقاتهم السياسية والاقتصادية، ما يمنح روسيا قطعة كبيرة من كعكة الاقتصاد الأوكراني في ضوء تركز الصناعة في الأقاليم الشرقية حيث يعيش الروس والناطقون بالروسية. وقد لجأت لتحقيق ذلك إلى تحريك الروس والناطقين بالروسية للمطالبة بحق تقرير المصير والدعوة إلى إجراء استفتاء حول الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا ترافق مع حشد عسكري روسي على الحدود المشتركة في مسعى لتعضيد موقف الانفصاليين من جهة وإحداث فوضى عارمة تعيق إجراء انتخابات رئاسية في 25/5/2014.
2- دولة مركزية مع لامركزية إدارية واسعة تمنح الأقاليم فرصة المشاركة في القرار الوطني على كافة الصعد السياسية والاقتصادية، وهو خيار تتبناه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالعمل على تكريس الوضع الجديد وإعطاء السلطة القائمة في كييف الشرعية من خلال إجراء انتخابات رئاسية فيها. وقد قاما، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ببعض الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية (عقوبات على شخصيات وشركات روسية وأوكرانية مع منعها من دخول أراضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) والعسكرية (نشر لواء من قوات الناتو في دول البلطيق، إجراء مناورات بحرية في البحر الأسود وأخرى برية، وقيام طائرات لحلف الناتو بدوريات فوق دول البلطيق، مد القوات الأوكرانية بعتاد عسكرية) لتدعيم موقف السلطة الجديدة.
3- تصعيد الأزمة لانعدام أرضية مشتركة لحل متفق عليه والذهاب إلى حرب أهلية، تأخذ شكل حرب بالوكالة تغذيها دول داعمة لطرفي الصراع، مع احتمال تفكك الدولة والانزلاق نحو تقسيم البلاد إلى أوكرانيا شرقية مرتبطة بروسيا وأوكرانيا غربية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.
لكن ومهما يكن الاتجاه الذي ستأخذه الأزمة، فالواضح أنها لن تنتهي قبل أن تترك أثراً بالغاً على روسيا وجوارها الإقليمي والأوروبي.
ظلت المعطيات والمواقف المعلنة، على رغم تحرك الغرب المدروس بين الدبلوماسية والعسكرية، تنذر بتوترات ومواجهات عنيفة قد تستمر لسنوات تتوقف نتيجتها على مدى انخراط الجناح الأوروبي في الصراع، وعلى مدى تمسك الكرملين بما يسميه روسيا الجديدة، والتي تضم أراضي من دول الاتحاد السوفياتي السابق يقطنها روس أو ناطقون بالروسية، وعلى مدى إصرارها على إعادة النظر في ترتيبات ما بعد إنهاء الحرب الباردة.
سعى حلف الناتو إلى دمج أوكرانيا في صفوفه، من خلال دعمها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وإشراك قواتها في مناورات وتدريبات برية وبحرية وتشجيعها على التعاون والتنسيق الواسع، تمهيداً لانضمامها رسمياً إلى صفوفه. وقد شهدت الفترة الأخيرة تطوّراً ملحوظاً في قدرات الجيش الأوكراني في العدد والعتاد. زاد العدد من 120 ألفاً إلى 250 ألفاً، مع إبعاد الموالين لروسيا منه وتقويته بتجهيزه بأسلحة غربية متطوّرة؛ صواريخ دفاع جوي وراجمات صواريخ ورادارات وتقنيات مراقبة، ومسيّرات تركية من طراز بيرقدار، وإشراكه في مناوراتٍ بحريةٍ وبريةٍ مع قوات حلف الناتو لكسب الخبرات الميدانية والإدارية، دعمها الناتو لتتحول إلى قوة موازنة لروسيا على البحر الأسود، ما أثار حفيظة الأخيرة ومخاوفها من إحكام الطوق حولها؛ وقد عكست مطالبها من الحلف إلغاء بيانه الصادر عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا وجورجيا للحلف، وتقديم تأكيداتٍ ملزمة قانوناً بعدم نشر أسلحة حول روسيا، وفق بيان الخارجية الروسية، حجم هواجسها ومخاوفها من خسارتها أوكرانيا.
تشابك اقتصادي
لقد ألحق استقلال أوكرانيا بروسيا خسائر لا تعوض. إذ تميز النموذج السوفياتي بإقامة مجمعات صناعية ضخمة موزعة في فضائه، وبعد انهيار الدولة السوفياتية تلاشت غالبية هذه المجمعات العملاقة، حيث لم يعد ممكناً استمرار مجمع صاروخي في العمل مثلاً عندما تنتج أجزاء منه في ضواحي موسكو وأجزاء أخرى في كازاخستان أو في أوكرانيا أو بيلاروسيا. أما المجمعات الأخرى التي ورثتها أوكرانيا وما زالت تشكل قاعدة صناعية كبرى فظلت مرتبطة بصناعات مختلفة في بلدان أخرى، على رأسها روسيا. مثلاً، كانت مصانع أوكرانية تقوم بتقديم تقنيات لازمة لصناعة المحطات الكهروذرية الروسية، والمجمعات الصواريخ وغيرها من الصناعات الحيوية لاقتصاد البلدين. في الوقت ذاته، فإن السوق الأوكرانية من أضخم الأسواق بالنسبة إلى الصناعات الروسية، التي لن تكون في الغالب قادرة على منافسة الصناعات الأوروبية إذا سارت الأمور وفق السيناريو السيئ للروس بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعني خسائر كبيرة لقطاعات مهمة وحيوية سيكون عليها البحث عن أسواق جديدة لتعويض خسائرها الفادحة، فالتحاق أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي سيعني التزامها بعدد من المواثيق المشتركة، التي من بينها اتخاذ سياسات إقليمية ودولية تعارض مصالح موسكو، ما يعني أن تداعيات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون كبيرة وخطيرة، ويمكن أن تزداد خطورتها إذا كانت الخطوة التالية الانضمام إلى حلف الناتو، كما يرجح المحللون السياسيون، ما يعني إحكام تطويق روسيا عسكرياً، ونشر الصواريخ الغربية تحت نوافذ الكرملين مباشرة.
وما زاد في تعقيد الحالة حجم التداخل الاقتصادي الروسي الأوكراني الأوروبي، فالتجارة الأوكرانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بروسيا وأوروبا على حد سواء، فنحو 60 في المئة من حجم التجارة الأوكرانية تتم مع بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، كما أن أغلب منتجاتها الصناعية تأتي من المناطق الشرقية للبلاد ذات الكثافة الصناعية الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الروابط الشخصية التي تجمع عدداً كبيراً من المواطنين الأوكرانيين في الأقاليم الشرقية بروسيا المجاورة، فيما تظل أوروبا بالنسبة لهؤلاء بعيدة جداً. أوروبا من جهتها ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز والنفط الروسيين. فالاتحاد الأوروبي يُعَد من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الكبار لروسيا، حيث تبلغ حصته في التجارة الخارجية الروسية نحو 50 في المئة. تمثل موارد الطاقة أساس هذه العلاقات عموماً، فنحو 36 في المئة من الغاز، و31 في المئة من النفط، و30 في المئة من الفحم من واردات دول الاتحاد الأوروبي مصدرها روسيا. وهذا يمثل 80 في المئة من إجمالي صادراتها من النفط، و70 في المئة من إجمالي صادراتها من الغاز، و50 في المئة من إجمالي صادراتها من الفحم، بينما تؤلف حصة الآلات والمعدات الروسية (السلع الاستثمارية) أقل من 1 في المئة. فروسيا تحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين في التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي بحصة تعادل 7 في المئة من صادراته و11 في المئة من وارداته. وبهذا الشكل يوفر التعاون مع الاتحاد الأوروبي إيرادات مهمة للغاية لخزينة الدولة الروسية.
في الوقت نفسه، يصل من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى روسيا منتجات البتروكيماويات 18 في المئة والمواد الغذائية 10 في المئة والسلع الاستثمارية والتكنولوجية من معدات وآلات نحو 45 في المئة. وفي ما يتعلق بالتعاون الاستثماري، فإن 70 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي تعود إلى دول الاتحاد الأوروبي. وهذا يعكس الترابط العضوي بين الاقتصاد الروسي واقتصاد بلدان الاتحاد الأوروبي. وقد ظهر عمق التأثير المتبادل بين الاقتصادين الروسي والأوروبي في ضوء الإجراءات العقابية الأولى التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد شخصيات روسية وأوكرانية موالية لروسيا، حيث اهتز الاقتصاد الروسي بقوة، فقد تراجعت السوق المالية الروسية «مايسكس»، وفقدت 66 مليار دولار من أصولها بعد اندلاع الأزمة عام 2014، كما فقد الروبل 11 في المئة من قيمته، مما اضطرّ البنك المركزي الروسي للتدخّل وضخّ 16 مليار دولار لاستقرار العملة. كما انسحبت استثمارات تُقدّر بـ 50 مليار دولار من الأسواق الروسية، علاوة على ذلك، فإن التبادل التجاري بين روسيا وأميركا يزيد عن 40 مليار دولار.
وقد أنشأت أوكرانيا خلال السنوات الثماني الماضية علاقات اقتصادية مزدهرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث انضمت إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية، كما عززت علاقاتها الاقتصادية مع شركاء تجاريين آخرين، بمن فيهم الولايات المتحدة والهند ومصر وتركيا. وقد نجحت في تخفيض فاتورة الغاز عبر الاستعاضة عن الغاز الروسي باستيراد غاز روسي من أوروبا بعملية شحن عكسية مقدم من الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل؛ أدت هذه الخطوة التي نفذتها شركات وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى تحييد التهديد الروسي بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، إضافة إلى إشراف الاتحاد على خطة إصلاح لقطاع الغاز داخلها. وقد ساعد رفع أسعار الغاز للمستهلكين، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية، وخفض أسعار الغاز المستورد، والدعاوى القضائية الناجحة ضد شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي، التي حصلت بموجبها نفتوغاز الأوكرانية على 2.9 مليار دولار في عام 2019، على تعافي أوكرانيا في مجال الغاز. ووسعت التبادل التجاري مع دول الاتحاد ودول أخرى، فوفقاً للأرقام، قفزت الصادرات الأوكرانية إلى أوروبا من 24.9 بالمئة عام 2012، إلى 42.6 بالمئة، بينما قفزت وارداتها من الاتحاد الأوروبي إلى نحو 40 بالمئة بعدما كان 30 بالمئة عام 2012. ودخلت في علاقات تجارية مع الصين، حيث غدت الأخيرة في العام 2020 شريكا تجاريا رئيسيا لأوكرانيا، ثاني شريك تجاري. وقد قفزت الصادرات الزراعية بينهما في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك بسبب تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث باتت مصدراً مهماً لواردات الحبوب إلى الصين، ومن أهم مصادر تعزيز الأمن الغذائي في الدولة العملاقة. تستورد بكين من كييف، على سبيل المثال 80 بالمئة من واردات الذرة. كما دخلت في مشروع «الحزام والطريق»، خطة بكين الطموحة لربط العالم بشبكة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ، واعتبرت لاعباً مهماً فيه على خلفية موقعها الجغرافي بالنسبة لأوروبا.
لقد شهد الاقتصاد الأوكراني بعد الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية، التي تعفي واردات أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، انتعاشاً. وهذا شكل تحدياً كبيراً ومحركاً للتصعيد الروسي الحالي على حدود أوروبا الشرقية في محاولة لاسترداد الجارة السلافية والشريكة الاقتصادية، حيث نظرت روسيا إلى تمدد الغرب الاقتصادي إلى أوكرانيا تهديداً لاستقرار اقتصادها، وأن بمقدورها تقويض الاقتصاد الأوكراني وتأليب الأوكرانيين من هذا الباب ضد حكومتهم الموالية للغرب، وإفشال منطقة التجارة الحرة الأوروبية في الوقت نفسه، فالأخيرة تهديد لها كذلك.
تحركات ومواجهة
تحرّكت روسيا لمواجهة إصرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على إدماج أوكرانيا في التحالف الغربي؛ والعمل على إقامة قواعد بحرية على البحر الأسود في رومانيا وبلغاريا؛ ونشر قوات وعتاد في دول شرق أوروبا.
اعتمدت روسيا ثلاث خطوات متكاملة للضغط على الولايات المتحدة والناتو لتحقيق هدف رئيس، وهو الانخراط في مفاوضاتٍ على ترتيبات جيوسياسية وجيواستراتيجية تقود، في حال الاتفاق عليها، إلى إقامة غلافٍ استراتيجيٍّ لحماية أمنها القومي. أول هذه الخطوات حشد عسكري ضخم على الحدود الروسية – الأوكرانية، قدّر العدد بـ 150 ألف جندي مع عتاد ثقيل، طوّق أوكرانيا من ثلاث جهات. ثاني هذه الخطوات رفع سعر الغاز في ذروة فصل الشتاء، إذ يرتفع الطلب عليه للتدفئة، مع نقصٍ في مخزون الدول الأوروبية منه، قدّر المخزون الحالي بـ 63 بالمئة من احتياجاتها. وثالث هذه الخطوات تنظيم وإدارة عملية هجرة من دول في الشرق الأوسط إلى أوروبا، وتجميع آلاف من طالبي اللجوء على الحدود البيلاروسية – البولندية، ودفعهم إلى اقتحام الحدود إلى بولندا، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، أردفتها بإجراء مناوراتٍ بحرية؛ واحدة في البحر الأسود وأخرى مع البحرية الجزائرية غرب البحر الأبيض المتوسط؛ وبدفع صرب البوسنة إلى المطالبة بالانفصال عن جمهورية البوسنة والهرسك؛ وإجراء تجارب على صاروخ سيركون الفرط صوتي، وتدريبات على منظومة صواريخ إس 400 في شبه جزيرة القرم، وعلى صواريخ إسكندر في مقاطعة كورسك المجاورة لأوكرانيا، وبالتنسيق مع الصين، في ضوء هدفهما المشترك: إضعاف الولايات المتحدة وكسر الأحادية القطبية، عبر إجراء دورياتٍ بحريةٍ مشتركةٍ في المحيط الهادئ، وتوقيع اتفاق عسكري للتعاون، يقضي بزيادة التدريبات والدوريات المشتركة لقوات بلديهما، «رداً على نشاطات القوات الجوية الاستراتيجية الأميركية القادرة على حمل أسلحة نووية بالقرب من الحدود الروسية»، وفق قول وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وعقد قمةٍ افتراضية بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، ندّدا فيها بالخطاب الأميركي العدائي نحو بلديهما، وقمة مباشرة في بكين أعلنا فيها رفضهما للتدخل في شؤون الدول بحجة نشر القيم الديمقراطية واعتراضهما على النظام الدولي القائم الذي تتحكم به الولايات المتحدة. الهدف المباشر من الخطوة الأولى هو الضغط على الولايات المتحدة وحلف الناتو لسحب دعوة أوكرانيا إلى الانضمام إلى صفوف الحلف. ومن الخطوتين الثانية والثالثة، زعزعة استقرار دول الاتحاد الأوروبي عبر إشاعة تذمر واحتجاجات شعبية على فقدان الغاز وارتفاع الأسعار الكبير الذي حصل، وبذر الشقاق بينها حول الموقف من اللاجئين وسبل مواجهتهم وتقاسم عبئهم، والخطوات الرديفة لمشاغلة الناتو والاتحاد الأوروبي بقضايا بجواره وفي عقر داره.
رفض حلف الناتو المطالب الروسية، سحب دعوته أوكرانيا إلى الانضمام إلى الحلف وتقديم تعهدات مكتوبة بعدم نشر قوات وعتاد في أراضي الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وأعلن تمسّكه بحق أوكرانيا في الاختيار؛ وعقد اجتماعاً لوزراء دفاعه في ريغا عاصمة لاتفيا يوم 21/10/2021، وأصدر بياناً يحذّر فيه روسيا من الإقدام على غزو أوكرانيا؛ وتبنّى خطة لمواجهة هجوم روسي واسع من البلطيق والبحر الأسود؛ وتذرّع بالحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، وبكلام الرئيس الروسي عن روسيا التاريخية التي تشمل كلّ الأراضي التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي، ونشر عتاداً عسكرياً في بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وقد عزّزت الولايات المتحدة موقف الحلف بإصدار تهديد لروسيا بعقوبات قاسية، أبلغها الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمتهما الافتراضية، وإجراء مناورات أطلسية في مياه فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمياه الدولية غرب البحر الأبيض المتوسط، أكبر المناورات البحرية خلال السنوات الأخيرة، للتدرب على محاربة الدول وتأمين الملاحة، وتلويح الولايات المتحدة بتعزيز الجناح الشرقي للحلف بتركيز انتشارها العسكري في أوروبا في جزئها الشرقي، وقيام طائرات أميركية بدوريات فوق البحر الأسود وعلى الحدود الشرقية لدول الحلف، وشحن أكثر من 120 مروحية وألف آلية عسكرية و1200 ناقلة جند مدرّعة من طراز إم1 117 إلى ميناء ألكساندروبولي اليوناني، تمهيداً لإرسالها إلى بلغاريا ورومانيا والمجر، والتنسيق مع أوكرانيا بتجهيز خطط لمقاومة الاجتياح روسي لأراضيها؛ خطط حرب عصابات وحرب شوارع وعمليات مقاومة خلف خطوط العدو، لخوض حرب استنزافٍ طويلة الأمد، تنهك القوات الروسية وتدفّع روسيا، وبوتين تحديداً، ثمناً باهظاً بتكبيدها خسائر مادية وبشرية كبيرة، وتوسيع دائرة الضغط على روسيا، بالإعلان عن موقفٍ صلبٍ من التحرّك الروسي لصياغة حل للصراع في سورية وعليها، بتأكيدها أنّ قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للحلّ.
ردّت روسيا على الرفض الغربي لمطالبها بإرسال قاذفات قنابل إستراتيجية بعيدة المدى من طراز تو-22 إم 3 للانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد، حيث تقوم مقاتلات سو – 30 إس إم روسية وبيلاروسية بدوريات جوية مشتركة على الحدود الغربية للبلدين، وإجراء مناورات لاستخدام أسلحة نووية. وكان لافتاً قول وزارة خارجية بيلاروسيا إنّها تدرس نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها حال تعرّضها لتهديد من الناتو، مرفقة بدعوة من بوتين إلى حوار أمني فوري مع الحلف، وإعلان بانسحاب روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة.
وضعت المواجهة الدائرة، بمناوراتها السياسية والعسكرية، مستقبل النظام الدولي على بساط البحث؛ فكلا طرفي الصراع يدير المواجهة بكل أدواتها ومستوياتها، مستغلاً كلّ نقاط قوته ونقاط ضعف خصمه، وعينه على اليوم التالي، على الانعكاسات الاستراتيجية لهذه الجولة، فالولايات المتحدة تعتبر التعاون الروسي الصيني موجّها ضد تحرّكها لاحتواء الصين، وتضع التنسيق الروسي الصيني والروسي الإيراني في خانة الصراع على واقع النظام الدولي ومستقبله. وهذا دفعها إلى تحريك الموقف شرق أوروبا لإشغال روسيا بأمنها الخاص، وإرضاء الكونغرس الذي يرى في روسيا خطراً أكبر من خطر الصين، ويضع مواجهتها في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأميركية، وطمأنة دول شرق أوروبا بأنّ إعطاء الأولوية للصين لا يعني غضّ النظر عن التهديدات الروسية لأمنها واستقرارها، فالنجاح في احتواء هذا الثلاثي وردعه ضرورة لتثبيت النظام الدولي الحالي الذي تجلس على قمته. والتحرّك الغربي للاستحواذ على أوكرانيا ليس جديداً أو مفاجئاً لروسيا، لكنّها انتظرت فرصةً للرد على المحاولة، وقد اعتقدت أنّها قد حانت، في ضوء انشغال الولايات المتحدة بترتيب أوراقها واستعداداتها السياسية والميدانية لاحتواء الصين، وبتبعات انسحابها الفوضوي من أفغانستان على صورتها، وقد اعتبر دليل ضعف، وعلى مصداقيتها؛ وإعادة تموضعها في الشرق الأوسط الذي أثار ردود فعل سلبية لدى حلفائها في الإقليم، دول الخليج على وجه الخصوص، وانخراطهم في مبادراتٍ سياسيةٍ تبعدهم عنها، بما في ذلك انفتاح استراتيجي على خصومها روسيا والصين وإيران، لصياغة معادلات جيوسياسية لاحتواء مفاعيل توجهها الجديد، وما يمكن أن ينجم عنه على صعيد توازن القوى وانعكاسه على أمنهم الوطني، وخلافها مع فرنسا على خلفية صفقة الغواصات الأسترالية؛ وبحالة المراوحة في مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، وتبعات تآكل بنيتها التحتية ومفاعيل وباء كوفيد 19 على صورتها ومكانتها الدولية. تحرّكت روسيا معتقدةً أنّ لحظة النظام أحادي القطب قد اقتربت نهايتها، وأنّ في استطاعتها رفع التحدّي في وجه حلف الناتو، ودفعه إلى التراجع عن عرضه لأوكرانيا واعتبار التراجع، إن حصل، مؤشّراً على تبدل توازن القوى، وعلى ولادة نظام دولي جديد بتوازناتٍ تكون فيها قوة موازية للولايات المتحدة؛ القوة الرئيسة في التحالف الغربي.
لقد حشر الرئيس الروسي نفسه بعسكرة الدبلوماسية، ولم يعد قادراً على التراجع. صحيح أن هناك داخل روسيا من يقف معه في وجه الغرب لأسبابٍ استراتيجية، لأن الرضوخ أمام إدخال أوكرانيا عضواً في حلف الناتو يفتح الباب لتوسيع عضوية الحلف وإدماج آخرين فيه، وهذا يطوّق روسيا ويهدّد وجودها. لكن هناك من يقف ضد الحرب وخسارة إمكانيات بشرية ومادية البلد في حاجة ماسة إليها في ضوء تآكل القدرات الشرائية وتراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية. فالتخطيط للحرب أضر بروسيا من حيث العزلة الدولية والعقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ونسف دخول القوات الروسية إلى أراضي أوكرانيا في لوغانسك ودونيتسك مصداقية بوتين الذي يطالب باحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على وحدة أراضيها تبريرا لدعمه للنظام السوري، خاصة وأنه بفعلته قد خرق تعهداً روسياً أميركياً بريطانياً لأوكرانيا وقع عام 1994 يتضمن حماية استقلالها ووحدة أراضيها مقابل تخليها عن الأسلحة النووية السوفياتية المنشورة على أراضيها. في المقابل أثار تمدد حلف الناتو في دول شرق أوروبا واقترابه من الحدود الغربية الروسية وفتحه الباب لانضمام أوكرانيا وجورجيا إلى صفوفه هواجس ومخاوف روسيا ومنحها فرصة للاعتراض على النظام الدولي القائم وما يدفع نحوه بذريعة نشر القيم الديمقراطية.
سيكون لنتائج الصراع على أوكرانيا أثر واضح على النظام الدولي إن لجهة بقاءه غربياً مع تكريس وتعميق أسسه وقواعد اشتغاله أو لجهة دخول العالم في سيرورة لبناء نظام بديل على أسس وقواعد جديدة تلحظ موقع ودور أنظمة دولية صاعدة مثل الصين وروسيا والهند.
موقع الجمهورية
—————————
روسيا تخوض الحرب… أميركا تريد احتواء الجميع/ منير الربيع
مسار بعيد المدى من التداعيات والتبعات للغزو الروسي لأوكرانيا. لا يمكن قراءة واستشراف النتائج الجيوستراتيجية التي ستنتج عن هذا الاجتياح، ولكن أثره سيكون بالغاً بالتأكيد أولاً على روسيا وأوكرانيا، ثانياً على أوروبا، وثالثاً على النظام العالمي، ورابعاً على منطقة الشرق الأوسط التي تعج بالصراعات السياسية والاستراتيجية على إيقاع الصراع المفتوح حول الانتماء إلى أي من المحاور. مع الأيام الأولى لبدء الاجتياح، تحمّس كثر على طرفي نقيض. فمن يؤيد موسكو سارع إلى الإعلان عن الانتصار الساحق وإسقاط كييف في ساعات قليلة، ولكن ذلك لم يحصل. فيما المعارضون لروسيا والذين يتعاطفون مع أوكرانيا سارعوا إلى خطّ حروف الإيمان بالمقاومة الملحمية التي قدّمها الأوكران دفاعاً عن بلدهم في مواجهة القوات الروسية.
كلا القراءتين نتجتا عن حماسة وتسّرع، بينما النتيجة هي ضربة قاسمة لأوكرانيا، على الرغم من الصمود، من الذهاب إلى خيار المقاومة الشعبية والتي قد تطول وتتطور إلى حرب استنزاف. بينما روسيا وبحال طالت الحرب فستكون أمام مآزق متعددة وحالات التظاهر التي شهدتها بعض المدن الروسية اعتراضاً على الحرب، بالإضافة إلى التظاهرات التي شهدتها دول متعددة كانت سابقاً في الاتحاد السوفييتي ستتعاظم كنوع من الدخول في صراع إرادات مع روسيا. سعى بوتين في البداية إلى الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لتبرير دخوله العسكري، ووجه نداءات إلى الجيش الأوكراني بضرورة القيام بانقلاب عسكري واستلام السلطة وذلك لتجنب حرب الاستنزاف.
في المقابل لوح الغرب بإنتاج المقاومة المسلحة والتحول إلى حرب العصابات، مع تحميل روسيا مسؤولية الدمار الذي يحصل مقابل استدراجها إلى ضربات متنقلة قد يتلقاها الجيش الروسي. وبالتالي عدم الحسم العسكري سريعاً، وهو الذي سينعكس سلباً على الواقع الروسي، خصوصاً في الانعكاسات المالية والاقتصادية، بنتيجة العقوبات التي يتم فرضها على روسيا، وهي عقوبات لو كانت قد فرضت منذ اجتياح جورجيا، أو ضم القرم، أو التدخل في سوريا، لما كان بوتين قد توسع طموحه وتنامى حلمه في ضرب أوروبا من خلال إعادة إحياء الحروب فيها، ما سيكون له نتائج كارثية على أوروبا ككل وعلى الاتحاد الأوروبي.
وفي ذلك، يحقق الأميركيون جملة من الأهداف، أولها إغراق روسيا في وحول هذا الصراع، ونسب لها تهمة إعادة إحياء الحروب في أوروبا، في المقابل، إضعاف أوروبا أكثر، اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، فأميركا في كل إداراتها لا تريد أوروبا قوية، وعندما تم الاتفاق على إنشاء الاتحاد الأوروبي، وكان السعي لإنشاء قوة اقتصادية كبرى، كان الرد الأميركي في زيادة نسبة هذه الدول في ميزانياتها بالحلف الأطلسي، وكذلك بالنسبة إلى الأسواق المفتوحة والتي نجح فيها الأميركيون بغزو الأسواق. حالياً يتكرر السيناريو على وقع الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بعدما كانت أميركا قد هددت مراراً بأنها لا تريد الاستمرار بتمويل الناتو، وبعد مواقف صريحة وعلنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه لا حاجة لاستمرار هذا الحلف.
إنه صراع يعيد تركيب النظام العالمي، تعتبر أميركا أن روسيا هي خطر وجودي، لذلك لا بد من الاستمرار في إشغالها في ساحات متعددة، وإعطائها أدواراً مختلفة في أماكن متعددة كنوع من إرضاء الطموح الكبير. المشكلة الأساسية تبدأ في الدرع الصاروخية، والمشكلة الثانية هي الجمهوريات الإسلامية، والتي قد تتحرك فيما بعد كنوع من تفكيك روسيا أو خلق مشاكل فيها بحال استمر مسار السعي إلى تصغير الكيانات. والمشكلة الثالثة هي الصراع الاقتصادي. وهنا لا يمكن إغفال وجود سياسة أميركية ينصح بها هنري كيسنجر بأنه لا يمكن احتواء روسيا والصين معاً. هذه كلها حاضرة في وقائع الصراع الروسي الأوكراني وخلفياته، والموقف الغربي منه ولا سيما الأميركي.
لن تتوقف حدود وتداعيات الصراع عند الخريطة الأوروبية. إنما سيكون انعكاسها قائماً عل إيران والاتفاق النووي، فبالنسبة إلى روسيا فلو كان الاتفاق النووي قد أنجز قبل العملية العسكرية لكانت واشنطن ستتفرغ لموسكو، أما إبقاؤه معلقاً فيبقي واشنطن منشغلة بملفات متعددة، وهذا قد يطيل أمد التفاوض بينما تجد طهران نفسها في موقع حرج غير قادرة على الخروج من العباءة الروسية ولا تريد تبني السياسة الروسية الواضحة كي لا تخسر الاتفاق. الصين كذلك الأمر وهي تسعى إلى لعب دور الوساطة إلى جانب تركيا وأذربيجان، وبحال نجحت أنقرة في تكريس دورها التوسطي سيؤدي ذلك إلى المزيد من النفوذ التركي في قلب أوروبا هذه المرة. هذه الوقائع كلها سيكون لها انعكاس في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الساحة السورية تحديداً التي لا بد من مراقبة وقائعها ويومياتها، حيث هناك دوريات مشتركة أميركية روسية، وروسية تركية، وهناك خطوط تماس عسكرية بين هذه الأطراف. لذلك لا يمكن للمعركة الروسية الأوكرانية أن تكون اختصاراً للحرب الكاملة، وليست ضربة عسكرية في سبيل فرض شروط تسوية سياسية التي وإن حصلت فسيكون لها ما يتبعها من معارك لاحقاً. كل الوقائع تشير إلى أن هذا النوع من الحروب الجيوستراتيجية قد بدأت للتو.
تلفزيون سوريا
—————————–
لا تنسَ الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط/ روبرت فورد ا
أقرأ العديد من التحليلات للآثار الجيوستراتيجية للحرب في أوكرانيا وتأثيرها الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. لكن لسوء الحظ، لا توجد مناقشة جادة حتى الآن حول الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط، خاصة سوريا واليمن. ومن الضروري ألا ننسى هؤلاء الناس.
أولاً، فيما يخص الجانب المالي لأزمة أوكرانيا، وبحسب الأمم المتحدة، لجأ نحو 370 ألف أوكراني إلى دول أوروبا الشرقية، وشأن اللاجئين في الحروب الأخرى، سوف يحتاج جميع هؤلاء إلى المساعدة. قبل أزمة أوكرانيا، لم تكن ميزانيات الدول المانحة للمساعدات الإنسانية كافية لمواجهة الأزمات في سوريا واليمن. والآن يجب أن تقدم هذه الميزانيات المجهدة المساعدة للاجئين الأوكرانيين.
في عالم مثالي، ستعزز الولايات المتحدة ودول أخرى ميزانياتها الإنسانية بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، إذا وجدوا المزيد من التمويل للمساعدات الإنسانية، فستذهب الزيادات في الغالب إلى اللاجئين الأوكرانيين وليس السوريين أو اليمنيين الذين يحتاجون أيضاً إلى المزيد من المساعدة.
تعد ألمانيا مثالاً جيداً، فقد قدمت برلين في مارس (آذار) الماضي أكبر قدر من المساعدات الإنسانية في المؤتمر الدولي لجمع الأموال للعمل الإنساني مع اللاجئين السوريين والنازحين السوريين في مناطق مثل إدلب. ووعدت ألمانيا وحدها بتقديم 1.74 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلث إجمالي أموال المؤتمر. كان تعهدها ثلاثة أضعاف حجم التعهد الأميركي… (المنظمات الإنسانية قالت إنها ستحتاج إلى عشرة مليارات دولار لكنها جمعت ستة مليارات فقط). والسبت الماضي، رداً على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستزيد بسرعة إنفاقها على قواتها العسكرية إلى 100 مليار يورو مقارنة بالخطة الأصلية التي تقضي بإنفاق 53 ملياراً في عام 2022، وفي الوقت نفسه، يتعين على الاقتصاد الألماني أن يدفع أسعار طاقة أعلى بكثير. ويبدو من غير المحتمل أن تجد أموالاً جديدة كبيرة في عام 2022 لزيادة المساعدات الإنسانية للشرق الأوسط.
لذلك، ستحد الأزمة الأوكرانية من الموارد الجديدة للمانحين المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه سترفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم. نتيجة لذلك، فكل دولار أو يورو سيشتري طعاماً أقل في 2022 مما كان عليه في 2020 أو 2021، وهو ما سيحدث في لحظة عصيبة. في ديسمبر (كانون الأول)، قال وسيط الأمم المتحدة غير بيدرسون إن أكثر من 12 مليون سوري يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام، وقد تجمد العديد من الأطفال حتى الموت في مخيمات بإدلب.
في الوقت نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 16 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة، حيث قال مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن ألف يمني يموتون من الجوع أسبوعياً. وبالطبع، سيكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحدياً رهيباً لملايين اللبنانيين من غير اللاجئين الذين يعانون من انهيار الاقتصاد اللبناني.
في النهاية، لا يمكن أن يتأتى حل مشاكل اللاجئين والمشردين إلا من اتفاقيات السلام وإعادة الإعمار بمساعدة الدول الأكثر ثراء. وأزمة أوكرانيا لن تجعل هذا الأمر سهلاً، لأن العلاقات بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو من جهة أخرى، هي الأسوأ منذ أربعين عاماً. فبينما توجّه واشنطن وحلفاؤها ضربات قاسية للقطاع المالي الروسي، فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيمنح موسكو فرصاً للرد على المصالح الغربية.
تتمثل إحدى نقاط الضعف بالنسبة للغرب في النازحين في أماكن مثل إدلب في سوريا، وليبيا. على سبيل المثال، سينظر بوتين فيما إذا كان سيستغل الوضع المزري لملايين المدنيين في إدلب الذين يعتمدون على المساعدات عبر الحدود القادمة من تركيا بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويدرك بوتين أن حق النقض الذي يستخدمه يمنحه أداة مفيدة ضد تركيا وأوروبا عندما ينظر مجلس الأمن في تجديد قناة المساعدة هذه في غضون أربعة أشهر. وبالمثل، فإن العملية السياسية في ليبيا تعاني، وهناك خطر اندلاع صراع جديد بين الحكومة في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة وحليف روسيا المشير خليفة حفتر. قد يخدم القتال الجديد مصلحتين روسيتين: فقد يتسبب في موجات جديدة من اللاجئين من ليبيا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وسيبطئ تطوير قطاع النفط الليبي ليحل محل الطاقة الروسية في الأسواق الأوروبية. وبينما تدرس روسيا دفع المزيد من اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا، ستعطي الدول الأوروبية اللاجئين الأوكرانيين الأولوية.
وحتى أكراد العراق الذين يتمتعون بتعاطف خاص في العديد من الدوائر الغربية وجدوا الأبواب مغلقة في الغابات البولندية عندما حاول اللاجئون الأكراد دخول الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي.
آمل أن يحل السلام في أوكرانيا، ولكني آمل أيضاً ألا ننسى ملايين الأشخاص اليائسين في الشرق الأوسط الذين سيحتاجون أيضاً إلى المزيد من المساعدة.
– خاص بـ«الشرق الأوسط»
—————————
في الآثار الاقتصادية لأزمة أوكرانيا/ جواد العناني
في الحرب الاقتصادية التي دارت رحاها بين الصين والدول الغربية، وبخاصة الولايات المتحدة، تبينت لنا مجموعة من الحقائق الأساسية، فالتجارة والاستثمارات مع الصين كبيرة، وتسير باتجاهين، معظمها لصالح الميزان الصيني، وأنّ أيّ قيودٍ تُفرض على شكل عقوباتٍ على الصين ستنطوي على كلف أكبر على الاقتصادات الغربية.
والأمر الثاني أنّ في الصين استثمارات أميركية وأوروبية ويابانية كبيرة جداً، وأنّ لديها منصّات إلكترونية (هواوي) كافية لتسيير معاملاتها النقدية الدولية. وإذا حرمت من خدمات نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، فإنّها قادرةٌ على تعويض ذلك.
ولذلك أدّت الحرب الاقتصادية مع الصين إلى هبوط القدرة على إنتاج “المايكروشيبس” ما أخّر صناعاتٍ كثيرة، خصوصا السيارات والهواتف والكمبيوترات الشخصية، وغيرها من الوسائل الذكية. وكذلك ارتفعت كلف الشحن العالمية، وغيرها من الأمور.
ولذلك استطاعت الصين أن تحدّ من حجم الأذى الذي سيلحق بها من تلك الحرب. وتدلّ المؤشّرات الاقتصادية على أن الصين قد استفادت في ميزانها التجاري، وفي إنتاجها، وحتى معدلات نموها، على الرغم من القيود المشدّدة التي فرضت على حركة الشعب الصيني في المدن الكبيرة، خصوصا بسبب كورونا.
ولكن روسيا، بالمقارنة، لا تستطيع عمل ذلك، فهي تعتمد كثيراً في اقتصادها ودخلها الحكومي على علاقاتها مع الغرب، وأوروبا بشكل خاص، فالنفط والغاز يصدّران إلى أوروبا. وإذا ما وجدت هذه الدول وسائل لتقليل استيرادها، فذلك سيكون له عواقب واضحة على دخل روسيا من صادراتها الأحفورية، وعلى موازنة الحكومة التي تعتمد في 40% إلى 50% من دخلها على الإيرادات المتأتية من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وكذلك، فإنّ مقاطعة التعامل مع البنوك الروسية، وتجميد أموال البنك المركزي الروسي في البنوك الغربية، ومنع روسيا من الاستفادة من نظام “سويفت”، وحرمان طيرانها من استخدام الأجواء المحيطة بها سينطوي أيضاً على آثار سلبية تتجلّى فوراً بانعكاسات سلبية على سعر الروبل الروسي (انخفض بسرعة بنسبة وصلت إلى 70% حيال الدولار الذي صار يساوي 100 روبل)، وفي تراجع أسواق البورصة التي عطلت السلطات الروسية نشاطها.
ويبقى السؤال: هل غابت هذه الأمور كلها عن ذهن المخطط الاستراتيجي الروسي عندما استفزّ إلى حدّ إرسال قوات لاحتلال أوكرانيا، والعمل على تغيير القيادة الحاكمة فيها. وقد فاجأ قرار الغزو الروسي الصين، التي أخذت موقفاً شبه محايد، تجلى في امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن، وعن إصدار بيانات تدعم الموقف الروسي حيال قرارات المقاطعة الاقتصادية، ولكنها تدعو، في الوقت نفسه، إلى انهاء الأزمة في أوكرانيا بالطرق السلمية.
والسؤال: ماذا لو استمرّت روسيا في عنادها، ومضت في إبقاء وجودها العسكري في أوكرانيا، وأصرّت على استقلالية المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ماذا سيفعل الغرب؟ إلى أي درجة يمكن أن تتفاعل المقاطعة والحصار الاقتصادي ضد روسيا، بحيث تجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن يعيد النظر في حركته الاستراتيجية؟
أوقع الغزو الطرفين، الروسي والغربي، بين فكّي الكماشة، فليست روسيا ناجية من العواقب إذا تنازلت للطرف الآخر، ولا هي محققة انتصارا إذا استمر كل من الطرفين في الإصرار على موقفه، لأن هذا سينتج ديناميكيات جديدة صعبة ومعقدة.
أولها أن هدف الدول الغربية الرامي إلى ضم روسيا لتكون جزءاً من التحالف الغربي ضد الصين ربما يفشل، وتقوم روسيا والصين بالتعاضد معاً، وهو أمر له كلفة على الجميع، بدءاً من روسيا والصين والولايات المتحدة وحلفائها.
وثانياً أنّ هذه الحالة سوف تدخل العالم في نفق اقتصادي مظلم سيبدأ بارتفاع الأسعار، واحتمالية انهيار نظام النقد العالمي، وحصول فوضى عارمة في أسواق النقد والمال والسلع الأساسية.
ولن تقف المشكلة عند الكساد التضخمي (stagflation)، بل سيحصل انهيار اقتصادي (depression)، نرى فيه طوابير الجياع والعاطلين من العمل والمجرمين يجوبون الشوارع. وهذا سينتهي بحربٍ نوويةٍ مدمّرة لمعظم العالم.
هذا السيناريو الرهيب يمكن أن يحصل، ولكن ربما يكتفي المتخاصمون بحروبٍ ومناكفاتٍ محلية في أماكن مختلفة. وقد يكون بعضها مفيداً، وبعضها الآخر ذا ضرر كبير، فقد تدفع الحرب الأوكرانية الغرب إلى الوصول إلى اتفاق نووي في فيينا مع إيران، ويسعون من خلاله إلى فكفكة احتمال تضافر باكستان مع ايران مع أفغانستان، ما كان سيشكّل تهديداً للمصالح الغربية في وسط آسيا، وفي دول بدأت تشهد قلاقل كالتي حصلت في كزاخستان وأوزبكستان وقرغيزيستان؟
وهنالك أيضاً احتمالية الضغط على تركيا لاغلاق ولو فترة مؤقته، مضيقي الدردنيل والبوسفور، في وجه الملاحة الدولية، ما سيجعل من الصعوبة على السفن الحربية والتجارية الروسية العبور من البحر الأسود إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط. وعندها يثور السؤال: هل بالإمكان حصول اقتتال على سورية بين الغرب وروسيا؟
ولكن الأمر الأهم في المدى القصير أن الدول العربية سوف تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
وفي المقابل، ستجد أن ميزانها التجاري والخدمي (الميزان الأساسي) سوف يعاني من ارتفاع كلف المواد الغذائية (القمح، الأرز، السكر، الذرة، الصويا، الأعلاف وغيرها)، ومن ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصا المطلوبة للإنشاءات، مثل الحديد، والألمنيوم، والخشب، والفضة، والزنك. وكذلك ربما تتراجع العوائد السياحية، وكذلك كلف النقل والشحن والتأمين التي يتوقع ارتفاع مخاطرها وأكلافها.
والأردن هي الدولة العربية المصدرة للبوتاس قد تتعرّض ثانية لإغراق الأسواق بهذه المادة من بيلاروسيا التي تتمتع بوافر كبير منها على شكل مناجم أو محاجر. وقد حصل هذا سابقاً في السنوات 2012-2015، وتسبّب للأردن بخسائر واضحة في هذه المادة التصديرية الهامة.
إذا طالت أزمة أوكرانيا، فالباب مفتوح على سيناريوهات كثيرة، قد تتفاوت في حجم تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي ككل، والاقتصادات الوطنية فرادى. ولكن من الصعب التنبؤ بما يجري، لأن اللاعبين الأساسيين لا يدرون ماذا ستكون ردود فعلهم وأفعالهم على المديين، المتوسط والطويل، في خضم هذه الحرب المعقدة.
العربي الجديد
—————————
أوكرانيا .. الشجرة التي تخفي الغابة/ محمد أحمد بنّيس
يصعب التكهن بمآل الغزو الروسي لأوكرانيا في ظل التعقيدات الجيوسياسية للأزمة. صحيح أنّ هناك فرقاً كبيراً في القدرات العسكرية بين الجيشين، الروسي والأوكراني، إلّا أنّ دخول القوى الدولية الكبرى على الخط، وتهديدَ الأزمة التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في أوروبا والعالم، والتكلفة المادية والإنسانية الباهظة المتوقعة للحرب، ذلك كله قد يربك روسيا أكثر، أمام حزمة العقوبات التي تنتظرها، فالمضي في تنفيذ استراتيجيتها القاضية بوقف تمدّد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو حدودها، قد يدفع الأمور إلى الخروج عن نطاق السيطرة بالنظر إلى الحسابات الجيوسياسية المعقدة، ولا سيما أنّها لا تمتلك اقتصاداً قوياً قادراً على رفع التحدّيات التي تواجهها، على الرغم مما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة.
ليست الأزمة الأوكرانية، في الواقع، إلّا الشجرة التي تُخفي الغابة، فالأمر يتعلق بصراع استراتيجي تتجاوز حدودُه الإقليم نحو البنية الأمنية والجيوسياسية لأوروبا. وتمثل الثقافة السياسية للنخبة الروسية مدخلاً إلى إضاءة جوانب كثيرة من هذا الصراع الذي تمتد جذوره إلى فترة الحرب الباردة، حين كان الاتحاد السوفييتي لاعباً رئيساً في السياسة الدولية. ومن هنا، يعتبر فلاديمير بوتين ابناً شرعياً للمدرسة السوفييتية، بتصلّبها العقائدي والإيديولوجي والسياسي، وقد كان شاهداً على تفكّك الإمبراطورية السوفييتية. ولذلك ما فتئ يعتبر زوال هذه الإمبراطورية ”كارثة جيوسياسية” فتحت الباب على مصراعيه أمام الغرب للهيمنة على النظام الدولي. وطوال العقدين المنصرمين، لم يألُ بوتين جهداً في إعادة بناء الدولة الروسية ذات الجذور القيصرية والستالينية، وتحديد أولويات الأمن القومي الروسي بما يضمن عودة روسيا إلى سابق عهدها، إبّان الحرب الباردة، قوة عظمى مهيبة الجانب. بيد أنّ ذلك كان يتطلب، وفق رؤيته، تحصين الجبهة الداخلية باجتثاث الحركات الانفصالية في الجمهوريات الروسية وترويض المعارضة، والسعي لإقامة تحالف استراتيجي مع الصين، وبناء تحالفات جديدة في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، ضمن مشروع لإعادة تحديد الدور الروسي في معادلات القوة والنفوذ في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وحوض المتوسط والساحل وجنوب الصحراء. وكانت الأزمة الجورجية (2008) إشارةً دالةً من الروس على رفض أي مسّ من الغرب بمجالهم الحيوي.
في المقابل، يبدو واضحاً أنّ الغرب غير مستعد للتورّط المباشر في الأزمة الأوكرانية لعدة أسباب، أبرزها عدم توافق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على استراتيجية موحدة لمواجهة روسيا، فمن مصلحة الولايات المتحدة تحويل الحرب، التي أرادها بوتين عملية عسكرية خاطفة، إلى حرب استنزاف تذكّر الروس بكوابيس الغزو السوفييتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، فيما ستكون تداعيات الحرب على أوروبا وخيمة، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والإنساني.
تبرّر روسيا اجتياحها أوكرانيا بالتمدّد المتواصل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً نحو حدودها، وترى في ذلك تهديداً لأمنها القومي. وبالتالي، تطالب قادته بالتخلي عن فكرة ضم أوكرانيا إلى الحلف، وتحجيم قواته في الدول التي كانت جزءاً من المعسكر الشرقي إبّان الحرب الباردة، غير أنّ ذلك يخفي هدفاً استراتيجياً آخر يسعى له الروس، إقامة نظام دولي متعدّد الأقطاب لا تكون فيه الهيمنة للغرب، بمعنى إعادة رسم ميزان القوى العالمي على غرار ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، غير أنّ إقامة هذا النظام لا يبدو رهيناً فقط بالنزعة السلطوية البادية في سلوك الرئيس الروسي، بل أيضاً بوجود فاعلين آخرين، وفي مقدمتهم الصين التي تبدو معنيةً أكثر بتحصين صعودها الاقتصادي، ما قد يعني تحفظها من بعض مخرجات السياسة الروسية.
ما يحدُث في أوكرانيا يُخفي وراءه حرباً باردة ضارية على النفوذ والقوة ومصادر الطاقة. ويدرك الروس أنّ فشلهم في استخلاص العائد السياسي من حملتهم العسكرية على أوكرانيا سيكون مكلفاً جداً على المدى البعيد، بسبب تداعياته على الداخل الروسي ونفوذهم الذي يتخطّى بالتأكيد المجال الحيوي الذي يشكّله حزامُ الجمهوريات السوفييتية السابقة.
العربي الجديد
—————————
من هو الأكثر عبقرية: بوتين أم ترامب؟
على عادته في اجتراح تصريحات غريبة، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«العبقري»، واقترح أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها، باتباع هذا الأسلوب العبقري مع جارتها المكسيك، وعلى عادته أيضا، في محاولة الالتفاف على أقوال واجهت استنكارا كبيرا، من دون التراجع عنها فعلا، علّق ترامب مجددا على الموضوع بالقول إن بوتين ذكي لأن «قادتنا أغبياء».
إصرار ترامب على أقواله، ليس ناتجا عن عناد أو مكايدة لخصمه بايدن، وليس غلطة سياسية يمكنه الالتفاف عليها بإعلان التعاطف، الكاذب على الأغلب، مع الأوكرانيين، فإعجاب الرئيس الأمريكي السابق بأساليب بوتين في السياسة الخارجية والداخلية معلوم، كما كانت محاولات بوتين لدعم ترامب، عبر محاولات التأثير على الأصوات الانتخابية معروفة أيضا.
يتجاوز الأمر شخصية ترامب نفسه، أو المسؤولين السابقين المقربين منه (مثل وزير خارجيته مايك بومبيو أطلق بدوره على بوتين أوصاف «رجل الدولة الذي يستحق الاحترام»، و«الموهوب» و«الداهية»)، وهو يتعلّق أكثر باتجاه متعاظم ضمن اليمين الأمريكي نحو التقارب مع الاتجاهات السياسية الدكتاتورية في العالم (والنازيّة أيضا، فقد حظي هتلر بمديح ترامب).
لقد أطلق انتخاب ترامب موجة انبعاث كبرى لليمين القومي المتطرّف والعنصريّ والدينيّ في أنحاء العالم، ومن جهته الأخرى، تحوّل النظام الروسيّ بقيادة بوتين، إلى داعم كبير لتلك الاتجاهات، بحيث تشكّل طيف سياسيّ متواطئ يغذي بعضه بعضا، يمتدّ من الصين وروسيا والهند وكوريا الشمالية وإيران، مرورا بأحزاب اليمين العنصري في أوروبا، التي تلقى بعضها دعما ماليا، وليس سياسيا فقط، من موسكو، ودخلت في هذا السياق حكومات تتبع الاتحاد الأوروبي، كحكومة فيكتور أوربان في هنغاريا، وصولا إلى رئيس البرازيل الحالي جايير بولسونارو.
باستثناء إيران، التي تشتبك في مواقع عديدة مع إسرائيل، فقد كانت تل أبيب، خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو، بؤرة كبيرة للقاء الاتجاهات اليمينية المتطرّفة في العالم، وقد حافظ حلف ترامب – بوتين، على العلاقات الحميمة مع إسرائيل، وقد شهدت تلك الفترة ضغطا هائلا على الفلسطينيين، تمثّلت أهم عناصرها باعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبهجمة «صفقة القرن» السيئة الصيت، وبرعاية مشروع «الاتفاقات الإبراهيمية»، في مقابل إقفال الأبواب السياسية أمام الفلسطينيين، ومنع الأموال عنهم، ودعم الاستيطان المكثّف، والعمل على إلغاء حقوقهم، بما فيها حقوق اللاجئين بالعودة.
هذه أمثلة عن «عبقرية» ترامب، فماذا عن بوتين؟
يعدد مقال لمحلل سياسي روسيّ، يدعى ألكسندر نازاروف، ما حصل في العالم بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فيلاحظ أن سويسرا المحايدة انضمت للعقوبات على موسكو، وأن فنلندا، المحايدة أيضا، تدرس طلب الانضمام للناتو.
تحرق أوروبا، حسب المقال، جسور العلاقة مع روسيا. لقد أغلقت سماءها أمام الطيران الروسي، وجمد الغرب الأصول الروسية، وعزل بنوكها عن نظام «سويفت»، وتوقفت شركات الشحن الغربية عن نقل البضائع الروسية. لا تهدف العقوبات، كما يستنتج المقال، لخنق الاقتصاد الروسي، بل “لتدميره تماما”. تبعات ذلك على روسيا “كارثية تماما”.
الخلاصة العجيبة التي يخلص إليها المقال، تشبه توصيف ترامب لـ«عبقرية» بوتين، مستنتجا أن ما يفعله الرئيس الروسي سيكون «انتصار 1000 عام»، متوقعا نشوب حرب نووية، ينتصر فيها بوتين، لأن ترسانة روسيا النووية «أكبر وأحدث من الترسانة الأمريكية»!
من الصعب، ضمن هذا السياق، معرفة من هو أكثر عبقرية: ترامب أم بوتين؟
القدس العربي
————————
بين ألليندي وزيلنسكي/ بكر صدقي
لم يهرب الرئيس التشيلي الأسبق سلفادور ألليندي أمام هجوم القوة الغاشمة للسلطة الانقلابية بقيادة الجنرال بينوشيه، ورفض الاستسلام، فتحول مقتله (وثمة رواية تقول إنه انتحر) إلى أسطورة ثورية ألهمت الحركات اليسارية عبر العالم طوال السبعينيات وما بعد، بما لا يقل عن إلهام أسطورة تشي غيفارا للحركات الشبابية أواخر الستينيات.
كان ألليندي أول رئيس إشتراكي يصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وهذا نموذج فريد خارج السياق المألوف الذي لا يصل فيه اليساريون إلى الحكم إلا بنتيجة ثورة أو انقلاب عسكري، فيقيمون نسخة ما من “دكتاتورية البروليتاريا” التي عنت في الواقع دكتاتورية الحزب وقيادته وأمينه العام في آخر المطاف. كان هذا السياق مما يعزز التأويل الماركسي – اللينيني القائل إن النظام الديمقراطي ليس إلا تمويهاً خبيثاً يخفي تحته “دكتاتورية الطبقة البرجوازية”، فلا تمييز بين الحكم الديمقراطي في بريطانيا مثلاً والحكم النازي في ألمانيا الثلاثينيات. وبسبب ميزان القوى المختل سلفاً لصالح البرجوازية، لا يمكن تغيير النظام إلا بواسطة ثورة سلمية أو مسلحة، وغالباً مسلحة. أما وقد نجح ألليندي في الخروج من هذه الترسيمة، فقد خلخل ذلك ركناً أساسياً من أركان التعاليم السوفييتية، وهو ما يفسر عدم حماسة الشيوعية السوفييتية لـ”النموذج التشيلي”، فكان إسقاطه على يد الطغمة العسكرية، وبمساهمة فعالة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، “حلاً” لمشكلة وإبعاداً لخطر من وجهة نظر القيادة السوفييتية والحركة الشيوعية العالمية الدائرة في فلكها.
سقطت السلطة الاشتراكية في تشيلي و”عادت الأمور إلى نصابها” فارتاح الأمريكيون والسوفييت معاً، على رغم الفظاعات التي مارسها الجنرال بينوشيه بعد استيلائه على السلطة بحق الشيوعيين والاشتراكيين وعموم السكان، لكن أثر النموذج لم يزل كأنه لم يكن، كما أراد له خصومه من الجهتين، بل شكّل فاتحةً لتحولات كبيرة في الحركة الشيوعية العالمية، كانت أبرز نماذجها في نظرية “الشيوعية الأوروبية” التي تبنتها أكبر الأحزاب الشيوعية في أوروبا، الإسباني والإيطالي والفرنسي، وقامت أساساً على التخلي عن فكرة “دكتاتورية البروليتاريا” والاعتماد على صناديق الاقتراع في الوصول إلى السلطة وبناء النظام الإشتراكي بلا إراقة دماء أو استئصال طبقات اجتماعية، بل من خلال توافقات اجتماعية عابرة للطبقات.
ما هو وجه التشابه بين ألليندي 1973 والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم؟
زيلينسكي رئيس منتخب لدولة استقلت حديثاً عن الإمبراطورية السوفييتية، وصل إلى السلطة في عام 2019، في أعقاب تداعيات ثورة 2013 – 2014 “البرتقالية” التي أسقطت حكومة تابعة لروسيا ومضت في طريقها الخاص، تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي للاحتماء من الجارة القوية روسيا التي يقودها رجل لديه طموحات توسعية امبراطورية. ليس للرجل تاريخ عريق في السياسة، بل هو ممثل كوميدي محبوب من الشعب، لا شك أنه أدرك أن مهمته في قيادة بلاده نحو استكمال مهمات متطلبات الاستقلال والتحول الديمقراطي لن تكون سهلة، بالنظر إلى أن رد بوتين على ثورة الشعب الأوكراني لم تتأخر حين ألحق شبه جزيرة القرم بروسيا واستمر في تشجيع الانفصاليين الروس في دوندباس. وفي العام 2014 لم يكن لدى أوكرانيا جيش قادر على الدفاع عن البلد، وكان مخزون السلاح والذخيرة المتبقي من العهد السوفييتي عبارة عن خردة لا تصلح للاستخدام.
في السنوات الفاصلة بين 2014 واليوم أعيد بناء الجيش من الصفر، وتم تسليحه من جديد وإن لم يكن بالقدر الكافي لمواجهة عدوان بحجم العدوان الروسي. لكنه اكتسب خبرة قتالية في القتال ضد الانفصاليين الروس في دونباس، وتتحدث التقديرات اليوم عن نحو 40 ألف جندي يشكلون قوام الجيش الأوكراني بين جنود عاملين وجنود احتياط ممن أنهوا خدمتهم العسكرية وعادوا إلى الحياة المدنية.
يعتقد خبراء أن الرئيس الروسي لم يخطط لحرب شاملة وفق الخطط التقليدية المعروفة، بل لعملية عسكرية محدودة ومؤلمة من شأنها ترويع الأوكرانيين ودفعهم إلى الاستسلام السريع. ويلفتون النظر إلى أن الجيش الروسي لم يختبر في حرب حقيقية منذ الحرب العالمية الثانية، بل خاض “عمليات عسكرية” ضد أهداف سهلة كما في غزو المجر وتشيكوسلوفاكيا (1956، 1968 على التوالي) أو في الشيشان في التسعينيات، أو في سوريا وليبيا اليوم، أما في أفغانستان فقد تعرض لهزيمة مدوية شكلت مقدمة لانهيار الإمبراطورية السوفييتية. لذلك إذا لم يستسلم الأوكرانيون بسرعة ستضيق الخيارات أمام بوتين لأن التراجع عن أهدافه المعلنة لم يعد ممكناً.
لعب زيلينسكي دوراً مهماً في شحن عزيمة شعبه للمقاومة، ورفض عرضاً أمريكياً لترحيله لينجو بنفسه، وأكد على المقاومة في كل ظهوراته الإعلامية. لا شك أنه موقف شجاع فيه مخاطرة كبيرة، شخصية ووطنية معاً. فمن شأن انتصار عسكري روسي أن يجعله يتحمّل مسؤولية مقتل الجنود والمدنيين ودمار البنية التحتية والعمرانية وانتهاء استقلال أوكرانيا جميعاً، إضافة إلى مصيره الشخصي والعائلي. أما إذا فشل الروس في حملتهم فسوف يتحول إلى بطل وطني حتى لو تم اغتياله من قبل الروس.
هذا هو القرار الشجاع الذي يجمع بين ألليندي في قصره الرئاسي المطوق في 1973 وزيلنسكي في بلده المطوق والمحتل من قبل الجيش الروسي. ففي الحالتين ثمة قوة غاشمة تسعى إلى فرض إرادتها على رئيس الدولة لتركيع الدولة وإخضاعها. مات ألليندي وسقطت التشيلي تحت حكم بينوشيه، لكن إرث الليندي بقي وألهم الأجيال اللاحقة من التشيليين.
بالمقابل لا يمكننا أن نعرف الآن هل تخسر أوكرانيا الحرب أم لا، لكن قرار المقاومة بذاته أربك الروس وساهم في خلق رأي عام عالمي مناصر لأوكرانيا، وحوّل المساندة الغربية اللفظية إلى إجراءات عملية خانقة لروسيا، من خلال العقوبات الاقتصادية والعزل السياسي والرمزي والدعم المادي بالسلاح والذخيرة للجيش الأوكراني. كل هذا فاق التوقعات، وبخاصة توقعات بوتين نفسه، وهو ما دفعه إلى التلويح بالسلاح النووي.
كانت مقاومة أوكرانيا المحتملة لروسيا تشبه، في تصوراتنا، مقاومة نملة لفيل، وهو ما شجع بوتين على الاندفاع في مغامرة عسكرية تصورها خاطفة يعقبها استسلام أوكراني. قرار المقاومة هو الذي غير كل الحسابات.
٭ كاتب سوري
القدس العربي
———————–
في تذكّر خروتشوف بمناسبة حرب بوتين/ وائل السواح
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1962، قاد الطيار الأميركي، الرائد ريتشارد هيزر، طائرة تجسّس أميركية من طراز U-2 على ارتفاعات عالية فوق كوبا، ورصد ظاهرة غريبة. كان الاتحاد السوفييتي ينشر صواريخ باليستية نووية متوسّطة المدى في الجزيرة المحاذية لساحل فلوريدا. شكّلت المعلومة صدمة هائلة للرئيس الأميركي، جون كينيدي ومستشاريه، فمع نقل هذه الأسلحة الهجومية، رفعت موسكو، إلى حدّ كبير، الرهانَ في التنافس النووي بين القوى العظمى، وشكّلت تهديداً وجودياً للولايات المتحّدة.
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وقف الرئيس كينيدي أمام الأميركيين يُخبرهم في خطاب تلفزيوني أن الزعيم السوفييتي وقتها نيكيتا خروتشوف قد نصب سرّاً منصات إطلاق صواريخ روسية سوفييتية في جزيرة كوبا، على بعد 90 ميلاً فقط من شواطئ الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس أن إدارته لن تقبل ببقاء هذه الصواريخ، وأن إدارته لن تقبل بأي تسوية، ثمّ أمر بفرض “عزل” بحري على كوبا، يمنع عنها عملياً التواصل مع العالم الخارجي.
قبل ذلك بثلاث سنوات، في الأول من يناير/ كانون الثاني 1959، قاد شاب قومي كوبي، يدعى فيدل كاسترو، جيشه المؤلّف من وحدات ثورية إلى هافانا، وأطاح الجنرال باتيستا، المدعوم من الولايات المتحدة. شكّل انتصار الشاب الثوري المقرّب من الثائر الماركسي الكاريزماتي، أرنستو تشي غيفارا، صدمة لواشنطن، أقضّت مضجع القادة فيها. وعلى مدى العامين التاليين، سيحاول المسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية ووكالة المخابرات المركزية إزالة كاسترو، تتوجّت بمحاولة لغزو كوبا في خليج الخنازير، في إبريل/ نيسان 1961، شارك فيها نحو 1400 كوبي ممن فرّوا من منازلهم عندما تولّى كاسترو السلطة، على أن العملية انتهت بفشل ذريع، واستسلم الغزاة بعد أقلّ من 24 ساعة من القتال. استغلّ الزعيم السوفييتي خروتشوف المحاولة الأميركية، فتوصّل مع كاسترو إلى اتفاق سرّي لنصب منصّات الصواريخ النووية.
شعر العالم برمّته لحظة أن الأرض تقف فعلاً على قرن الثور. واستمرّت الأزمة 13 يوماً، تناوبت فيها الدبلوماسية العلنية والسرّية للتوصّل إلى حلّ. والتقى وزير العدل وشقيق الرئيس، روبرت كينيدي، سرّاً السفير السوفييتي لدى الولايات المتحدة، أناتولي دوبرينين، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدّة لإزالة صواريخ جوبيتر التي كانت تثير القلق الشديد للسوفييت من تركيا. في صباح اليوم التالي، أصدر خروتشوف بياناً عاماً أعلن فيه أنه سيزيل الصواريخ السوفييتية من كوبا.
وتنفّس العالم الصعداء، في الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا وفي كلّ بقاع المعمورة. كانت تلك لحظة استثنائية، وقف العالم فيها على شفا حربٍ عالميةٍ ثالثة ما كانت لتبقي أو تذر. ولم تتكرّر هذه اللحظة مطلقاً، حتى جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وركب على الفرس روسينيتا، وصار يحارب طواحين الهواء، ولكن حربه على عكس سلفه الطيب دون كيخوته خلّفت دماراً وضحايا لا حدّ لها في كلّ مكان تدخّل فيه.
يتمتّع بوتين بدرجة عالية من أوهام العظمة، وصلت به إلى حدّ دفْعِهِ العالمَ نحو كارثة حقيقية. بدا في خطاباته الأسبوع الفائت وكأنه فاقدٌ عقلَه، حيث خاطب العالم في مناجاةٍ مديدةٍ مليئةٍ بالتاريخ المختلق والبارانويا التي تثير الشفقة. واتهم كذباً وبشكل عبثي الحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطياً بأنها فاشية وأنها ارتكبت “إبادة جماعية”، مستخدماً هذه الكذبة مبرّراً لأكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
من منظور بوتين المشوّه، لهذا الهجوم ما يبرّره. لقد تجرّأ الأوكرانيون مرّتين منذ مطلع هذا القرن على الانتفاض وإطاحة القيادة التي أرادت أن تبقي أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفييتي تابعاً يدور في فلك موسكو، وآخر شيء يمكن بوتين أن يتقبّله، أن يدرك الروس أن مثل هذه البدعة التي قد تهدد قبضته على السلطة – يمكن أن تمر دون عقاب. في عام 2004، نزل ملايين الأوكرانيين إلى الشوارع، فيما سيعرف لاحقاً بالثورة البرتقالية، ومنعوا وصول صبيّ بوتين فيكتور يانوكوفيتش إلى الرئاسة، ولكن الأخير فاز عبر انتخابات مليئة بالغشّ والتزوير، وأصبح رئيساً في عام 2010، إلا أنه طُرد من منصبه في عام 2014 من خلال احتجاجات حاشدة ضدّه بسبب رفضه توقيع اتفاق لإقامة علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.
رغب بوتين بشدّة في أن تراه الأجيال القادمة إحدى الشخصيات البارزة في التاريخ الروسي، جنباً إلى جنب مع إيفان الرهيب وبطرس الأكبر وكاترين العظمى، بل ولينين وستالين. وليشبه أسلافه هؤلاء، لا بدّ أن ُيظهِر نزعة إمبراطورية توسّعية. وبالفعل، سمعناه في عام 2005 يقول إن “زوال الاتحاد السوفييتي كان أعظم كارثة جيوسياسية في القرن”. وهو لذلك يريد أن يُذكَر باعتباره بوتين العظيم، الذي عكس “الكارثة” وأعاد الإمبراطورية الروسية، قيصرية أو سوفييتية، لا يهمّ، إلى غابر مجدها، ونحن نذكر كيف اكتسحت قوّاته جورجيا في عام 2008، ثمّ أوكرانيا أول مرّة في 2014، حيث قضمت منها جزيرة القرم. والحال أن بوتين كان يرى في أوكرانيا جوهرة التاج الإمبراطوري التي انتُزعت منه ظلماً، ولا بدّ من إعادتها.
ثمّة بين خروتشوف وبوتين شبه في الشكل والطباع، فكلاهما أصلع وقصير القامة، وكلاهما شديد الذكاء عصبيّ المزاج، ونتذكر جميعاً صورة بوتين عاري الصدر، وصورة خروتشوف وهو يلوّح بحذائه في الأمم المتّحدة. ولكنهما يختلفان في أمور كثيرة أيضاً، فخروتشوف لم يكن يأبه لشكله، وكان يتدحرج بكرشه الضخم دحرجة في المعامل والسهول وقاعات المؤتمرات، مرتدياً بدلاتٍ فاتحة اللون واسعة عليه، كأنه استعارها من صديق أضخم منه. بوتين، في المقابل، يحافظ على لياقة جسمه ويرتدي أفخر الثياب وينتعل حذاءً بكعب عالٍ مخفيّ، ولا يظهر إلا في قَصره، وغالباً ما يجلس متنائياً عن صحبه من ضيوفه أو المسؤولين في حكومته.
ولكن الخلاف ليس في الشكل فحسب. يسجَّل لخروتشوف أنه أنهى العهد الستاليني بجبروته وغولاكه. في 14 فبراير/ شباط، استمع 1500 مندوب والعديد من الزوار المدعوين إلى خطاب رائع من نيكيتا خروتشوف، السكرتير الأول الجديد للحزب، ندّد فيه بستالين وعبادة الشخص التي رعاها والجرائم التي ارتكبها، بما في ذلك إعدام أعضاء موالين للحزب وتعذيبهم وسجنهم بتهم باطلة. وألقى باللوم على ستالين في أخطاء السياسة الخارجية، وفشل الزراعة السوفييتية، وإصدار الأوامر بالإرهاب الجماعي، والأخطاء التي أدّت إلى خسائر مروّعة في الأرواح في الحرب العالمية الثانية والاحتلال الألماني لمناطق شاسعة من الأراضي السوفييتية. أصغى الجمهور إليه في صمت شبه مطبق، لم يقطعه سوى همهمة مندهشة. ولم يجرؤ المندوبون حتى على نظر بعضهم إلى بعض، وهم يسمعون سكرتير الحزب يكوّم اتهاماتٍ مروّعة لـ “أبي روسيا” أربع ساعات متواصلة. وفي النهاية، لم يكن هناك أي تصفيق وترك الجمهور في حالة صدمة.
بوتين، في المقابل، أعاد روسيا إلى حظيرة الدول القمعية بامتياز، وهو سمّم خصمه الرئيسي، أليكسي نافالني، وحين رفض الأخير أن يموت أو يبقى المنفى، اعتقله وأودعه السجن. وأرسل قواته لدعم نظام بشّار الأسد، أسوأ نظام دكتاتوري في القرن الواحد والعشرين، وساهم في قصف المستشفيات والمدارس والبنى التحتية والأسواق الشعبية. واستخدم حقّ النقض في مجلس الأمن 16 مرّة دفاعاً عن رجله في دمشق. واحتلّ جورجيا وقضم جزيرة القرم، وشنّ هجومه المجنون على أوكرانيا، ثم اعتقل آلاف الروس الذين تظاهروا في موسكو وبطرسبورغ ضدّ الحرب، وهدّد السويد وفنلندا، ولا يكترث بتدمير الاقتصاد الروسي وإعادة الروس إلى طوابير الزبدة.
لا وجه للمقارنة، إذاً، بين الرجلين. الأول أنقذ العالم في 1962 من حرب عالمية مدمّرة؛ الثاني يدفع العالم حثيثاً نحو مثل تلك الحرب. وقديما قال المتنبي: “وبضدّها تتبيّن الأشياء”.
العربي الجديد
—————————-
الامم المتحدة تدين الغزو: سوريا اعترضت ..وإيران والصين امتنعتا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، قراراً يستنكر “بأشد العبارات” الهجوم الروسي على أوكرانيا ويدعو موسكو إلى “سحب جميع قواتها على الفور”، في خطوة تهدف إلى عزل روسيا سياسياً.
وجاء القرار الذي حظي بتأييد 141 دولة من أصل 193، فيما عارضته 5 دول وهي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأريتريا وسوريا، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين وايران، في ختام جلسة طارئة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن واستمرت 3 أيام.
وصوتت أغلب الدول العربية لصالح القرار وعارضته سورية، فيما امتنعت كل من الجزائر والعراق والسودان عن التصويت. وحصل القرار على أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.
ويستنكر القرار بأشد العبارات ما يصفه ب”عدوان” روسيا على أوكرانيا في انتهاك للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويفرض القرار على روسيا التوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويطالب روسيا بسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط.
ودعت الأمم المتحدة روسيا إلى إلغاء قرارها بشأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك فوراً، كما يطالب قرار الأمم المتحدة جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المقيد إلى وجهات خارج أوكرانيا وتسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أوكرانيا لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص الموجودون في حالات الضعف.
وتأسف الامم المتحدة لتورط بيلاروسيا “في هذا الاستخدام غير المشروع للقوة ضد أوكرانيا”، داعيةً إياها إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.
وأدانت الامم المتحدة “جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”، داعيةً جميع الأطراف إلى “الاحترام الصارم للأحكام الدولية ذات الصلة القانون الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 حسب الاقتضاء، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعا قرار الامم المتحدة إلى “حل سلمي فوري للنزاع بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة والوسائل السلمية الأخرى”.
وفي المداخلات، استنكر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا في جلسة الأمم المتحدة الاربعاء، ما وصفه بأنه “إبادة جماعية” ترتكبها روسيا في بلاده.
وقال السفير الاوكراني: “لقد جاؤوا لحرمان أوكرانيا من حقها في الوجود نفسه..من الواضح أن هدف روسيا ليس فقط الاحتلال..إنها إبادة”. وأضاف “من السهل التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في وقت السلم..تعالوا ووقعوا عليه في زمن الحرب”.
من جهتها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمة ألقتها أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الأربعاء، إن روسيا خانت الأمم المتحدة “وينبغي عليها وقف عدوانها فوراً على أوكرانيا”.
ونددت غرينفيلد بما وصفته ب”الاجتياح الكامل لدولة عضو في الأمم المتحدة” بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعت روسيا إلى وقف “حربها التي لا مبرر لها ولم تأت نتيجة أي استفزاز”.
وقالت: “نقف سويا لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها للقانون الدولي وأزمة حقوق الإنسان البشعة التي نشهدها”، مضيفةً “يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.
في المقابل، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مداخلته إن “كييف أخطأت عندما ظنت بأنها ستعيد سيطرتها على دونباس بالقوة بدعم من الدول الغربية”.
وأضاف أن “جذور الأزمة الحالية في أوكرانيا تكمن في تصرفات السلطات الأوكرانيا نفسها”، وتابع: “السلطات الأوكرانية التي تم تسليحها مؤخراً وتحريضها من قبل عدد من الدول توهمت بأنه بإمكانها حل مشكلة دونباس عسكريا بمباركة المنسقين الغربيين”.
—————————————
=====================
=====================
تحديث 04 أذار 2022
———————–
روسيا في المستنقع الأوكراني لسنوات..والثمن سيكون باهظاً
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
تماشيًا مع التوقعات الغربية، والأميركية تحديدًا، أطلقت روسيا صباح يوم 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية شاملة في أوكرانيا حددت هدفها بنزع سلاح هذه الأخيرة والإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الساعي إلى ضمّ بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وهو ما ترفضه روسيا. جاء القرار الروسي بعد يومين فقط من إعلان موسكو اعترافها باستقلال إقليمَي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليَين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وردّت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي والناتو وآخرون، بفرض جملة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على موسكو، شملت الرئيس فلاديمير بوتين، والدائرة الضيقة المحيطة به. وزادت الدول الغربية من حجم مساعداتها الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا بهدف رفع تكلفة الغزو على روسيا. وقد دفعت هذه الإجراءات الرئيس بوتين إلى التهديد المبطن باللجوء إلى السلاح النووي، ما أجج المخاوف من إمكانية اتساع المواجهة وتصاعدها جراء خطأ في حسابات أحد الطرفين.
سلاح العقوبات
في سياق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا كان لافتًا التزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتنفيذ التهديدات التي أطلقها خلال قمة افتراضية جمعته بالرئيس بوتين، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، في محاولته ردع روسيا عن القيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا. وكان بايدن هدد حينها بفرض عقوبات اقتصادية “مدمرة” ضد روسيا، وتقديم دعم عسكري لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة هجومية متقدمة، والسعي لعزل موسكو دوليًا، إذا هي أقدمت على غزو أوكرانيا. وكان واضحًا الجهد الذي بذلته واشنطن في التنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، واليابان وأستراليا، وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، لمعاقبة روسيا. وقد تمكنت واشنطن من تجاوز مخاوف بعض شركائها اللذين قد تتأثر مصالحهم بشدة نتيجة فرض عقوبات معيّنة على روسيا، خاصة ما يتعلق منها بمنع بنوك ومصارف روسية من الوصول إلى نظام SWIFT للتعاملات المصرفية والتحويلات المالية الدولية. كما استُثني قطاع الطاقة الروسي من العقوبات؛ مراعاةً لمصالح الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمد كثير منهم على النفط والغاز المستوردَين من روسيا، في ظل عدم توافر بدائل سريعة ومجدية اقتصاديًا، وأيضًا، وربما الأهم بالنسبة إلى إدارة بايدن، منعًا لحصول ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، المرتفعة أصلًا، وهو ما سيضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها وبالمستهلك الأميركي الذي بات يدفع نحو 40 في المئة تكلفة إضافية للوقود مقارنةً بالعام الماضي، ما يؤثر في حظوظ الديمقراطيين في سنة انتخابية حاسمة. وتعدّ روسيا ثاني مصدّر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وأكبر مصدّر للغاز.
وقد اتبعت واشنطن وحلفاؤها أسلوبًا متدرجًا في فرض العقوبات على أمل أن يمنع ذلك روسيا من اتخاذ إجراءات تصعيدية أكثر في حربها ضد أوكرانيا. وجاءت أول دفعة من العقوبات مباشرة عقب اعتراف روسيا باستقلال إقليمَي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليَين. وشملت العقوبات الأميركية خط نقل الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، المعروف بـ “نورد ستريم 2″، وذلك بعد إعلان ألمانيا تعليق العمل به، وحظْر التعامل مع بنكين روسيَين، أحدهما عسكري. وتضمنت، أيضًا، منعًا لتداول الديون السيادية الروسية في الأسواق الغربية، إضافةً إلى فرض عقوبات على الأثرياء الروس المقرّبين من الكرملين وعلى أفراد عائلاتهم.
وبعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت إدارة بايدن بالتنسيق مع مجموعة السبع الكبار (G7)، إضافةً إلى أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، عن إجراءات للحدّ من قدرة روسيا على القيام بأيّ أعمال تجارية بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين الياباني في مسعى لتقييدها في النظام الاقتصادي العالمي. كما شملت العقوبات بنك “في تي بي” أكبر بنوك روسيا، الذي يمتلك وحده أكثر من ثلث الأصول المصرفية الروسية، إضافةً إلى أربعة بنوك كبرى أخرى، تمتلك مجتمعةً ما يوازي تريليون دولار أميركي. وتوسعت دائرة العقوبات لتشمل التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك أشباه الموصلات، وذلك بهدف الحدّ من إمكانيات روسيا في تطوير قدراتها العسكرية والمدنية، بما في ذلك صناعة الطيران، على نحوٍ يقلل كفاءتها على المنافسة عالميًا، ويسدد “ضربة كبيرة لطموحات بوتين البعيدة المدى”. وفي اليوم التالي (25 شباط/ فبراير) أعلن البيت الأبيض انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تستهدف الرئيس الروسي ووزير خارجيته، سيرجي لافروف، وبهذا يكون بوتين أول رئيس لدولة كبرى يخضع لمثل هذه العقوبات، ولينضم بذلك إلى رئيسَي بيلاروسيا وسورية، ألكسندر لوكاشينكو وبشار الأسد.
وفي 26 شباط/ فبراير قررت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا عزل عدد من البنوك والمصارف الروسية عن نظام SWIFT للتعاملات المصرفية والتحويلات المالية الدولية، وتوسيع دائرة الكيانات والأفراد، القريبين من الكرملين، بما في ذلك عائلاتهم، وتجميد أصولهم التي يمكن الوصول إليها في العالم، والحدّ من قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى احتياطاته من العملات الأجنبية، والمقدَّرة بـ 630 مليار دولار. ويعدّ استهداف البنك المركزي الروسي الضربة الأشد التي يتلقّاها الاقتصاد الروسي، وهي ترقى إلى محاولة تقييده، عبر حرمانه من الأصول والاحتياطات لتحقيق استقرار نقدي والتخفيف من وطأة العقوبات. وتعّد هذه الخطوة غير مسبوقة، إذ إنها تُتخذ أول مرة ضد دولة كبرى مثل روسيا.
وفي 28 شباط/ فبراير انضمّت الولايات المتحدة إلى دول أخرى في فرض عقوبات على صندوق الثروة السيادي الروسي وعلى إحدى الشركات التابعة له، ما ضاعف الضغوط على الروبل الروسي الذي فقد 30 في المئة من قيمته تقريبًا خلال الأسبوع الأول من الحرب. وفي الأول من آذار/ مارس 2022، أعلن بايدن في خطاب عن حالة الاتحاد أنّ وزارة العدل الأميركية ستشكل فريقًا لتعقّب ما أسماه “جرائم الأوليغارشية الروسية”. أضف إلى ذلك أنّ واشنطن ستنضم إلى حلفائها الأوروبيين “في إغلاق المجال الجوي الأميركي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا”.
حسابات المواجهة
على الرغم من تشديد الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أنهم لن يشاركوا عسكريًا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، إلّا إذا جرى الاعتداء على دولة عضوٍ في حلف الناتو، فإنّ هذا لا يمنع وجود قلق غربي من إقدام روسيا على مزيد من التصعيد. فمن جهة، بدأت العقوبات الاقتصادية تظهر على الاقتصاد الروسي، إذ انخفضت قيمة الروبل إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة إلى 20 في المئة لوقف تدهور قيمة العملة ومنع تدفّق الودائع من البنوك الروسية إلى الخارج. كما عانت أسواق الأسهم الروسية أسوأ انخفاض في تاريخها، إذ فقدت 33 في المئة من قيمتها، وإن استعادت جزءًا منها بعد ذلك، وخفضت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، تصنيف ديون روسيا بشدة أيضًا. ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي العقوبات على روسيا إلى إفلاس عدد من بنوكها وحدوث تضخّم هائل، ما قد يشعل فتيل اضطرابات شعبية داخلية تهدد حكم بوتين.
ومن جهة أخرى، تساعد الولايات المتحدة أوكرانيا عسكريًا؛ إذ تمدّها بمعلومات استخباراتية عن تحرّك القوات الروسية داخل أراضيها، وتزوّدها مع حلفائها بمساعدات وعتاد حربي بكميات كبيرة. وفي 27 شباط/ فبراير أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ الاتحاد الأوروبي سيموّل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وهذا ما تفعله دول أخرى في الناتو أيضًا. وكانت إدارة بايدن وافقت خلال عام 2021 على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار من الأسلحة نُقلت إليها في الأسبوع الأول من الحرب، مثل الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات. وسمحت إدارة بايدن لكييف بسحب ما قيمته 200 مليون دولار من مخزونات الأسلحة الأميركية التي جرت الموافقة عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بما في ذلك صواريخ جافلين، وتدرس تزويدها بصواريخ ستينغر المضادة للطائرات. وقامت ألمانيا بتغيير سياستها القائمة منذ الحرب العالمية الثانية ووافقت على تزويد أوكرانيا بـ 1000 صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر. وكذلك فعلت دول أوروبية معروفة بحيادها، مثل السويد، في حين قالت فنلندا إنها تدرس الأمر نفسه.
تزيد هذه الإجراءات من شعور الرئيس بوتين بالعزلة والحصار، وتخشى بعض الدوائر الغربية أن يدفعه ذلك إلى مزيد من التصعيد. وكان بوتين هدد مع بدْء اجتياح أوكرانيا بأنّ أيّ طرف سيتدخل في الأزمة سيواجه “عواقب لم يختبرها في تاريخه”.
خاتمة
لن تثني التكلفة الباهظة للعقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها الرئيس بوتين على الأرجح عن المضيّ قدمًا في بلوغ هدفه المتمثل بإخضاع أوكرانيا؛ إذ لم تنجح العقوبات في تغيير سياسات دول إمكاناتها أصغر بكثير من روسيا، كالعراق في عهد الرئيس صدام حسين، وكوريا الشمالية وإيران وسورية. ويعدّ الاقتصاد الروسي، من حيث الحجم، الحادي عشر عالميًا، بقيمة 1.7 تريليون دولار، وهو ما يؤهله للتأثير في استقرار الاقتصاد الدولي. ورغم أن الجيش الروسي يواجه صعوبات في أوكرانيا، جراء افتقاده القوة البشرية اللازمة لتغطية كل مسرح العمليات الأوكراني الواسع (600 ألف كيلومتر مربع) وضعف الإمدادات اللوجستية، فإنه يبدو في وضع سيمكّنه في النهاية من السيطرة على المدن الكبرى، وتحديدًا العاصمة كييف، وإن بتكلفة أكبر مما كان متوقعًا، نتيجة الدعم الكبير الذي تحصل عليه أوكرانيا من دول الغرب.
ولن تتوقف موسكو على الأرجح قبل أن تحصل على تعهدات واضحة بأنّ الناتو لن يقوم بتوسعات جديدة على حدودها. ويبدو أنّ الكرملين يسعى في المدى القريب إلى انتزاع أكبر تنازلات ممكنة من أوكرانيا، مثل استقالة رئيسها وحكومتها ونزع سلاح جيشها، واختيارها الحياد. لكن، وفي كل الأحوال، سيكون ثمن اجتياح أوكرانيا كبيرًا على روسيا جرّاء العقوبات غير المسبوقة التي فُرضت عليها، واحتمال دخولها في مستنقع يستنزفها سنوات، وفي ظل عدم وجود حلفاء أقوياء لها يمكنها الاعتماد على دعمهم، باستثناء الصين. لكن الصين لم تؤيد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، رغم أنها كانت ترفض محاولات توسّع حلف الناتو في شرق أوروبا ودوره المتزايد في منطقة المحيطَين، الهندي والهادئ. وعلى الرغم من أنّ الصين أعلنت أنها لن تلتزم العقوبات على روسيا، وأنها قد تستمر في شراء نفطها وربما تقديم قروض لها، فإنّ التوقعات ترجّح أنّها لن تغامر بتحدّي العقوبات الغربية على نحوٍ سافر، آخذةً في الحسبان مصالحها التجارية الكبيرة مع أوروبا والولايات المتحدة أيضًا.
—————————–
أي حرب باردة ينتظر العالم؟!/ أكرم البني
ليس تسرعاً أو نوعاً من التبسيط، اعتبار حرب روسيا على أوكرانيا منعطفاً نوعياً في العلاقات بين موسكو والغرب، عنوانها القطيعة والجفاء بدل الحوار والتشارك. والقصد أن من كان يعتقد أن الحرب الباردة قد انتهت بعد سقوط جدار برلين، عليه أن يتابع اليوم جديد المشهد العالمي.. قرار الرئيس بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، بعد أيام من إعلانه الحرب على أوكرانيا، ودخول جيشه من عدة محاور للسيطرة على ذلك البلد. عقوبات غير مسبوقة اقتصادياً ومالياً اتُّخذت ضد روسيا، تلتها قرارات بحظر طيرانها، ومنع بواخرها من استخدام المواني الغربية، وإبعاد فرقها الرياضية من المشاركة في المباريات العالمية والأوروبية، ربطاً بحماس الدول الأوروبية وأميركا وكندا، لإرسال أسلحة لتمكين الأوكرانيين من المواجهة والصمود، كما فتحت الأبواب لاستقبال ملايين اللاجئين منهم وتأمينهم.
كل ما سبق يذكِّر بمحطات شهدتها عقود من الحرب الباردة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط جدار برلين (1989)، وتفكك الاتحاد السوفياتي (1990)؛ لكن جديد هذه النسخة من الحرب الباردة، هو غياب البعد الآيديولوجي الذي كان عنواناً للصراع وقتئذٍ، بين المعسكرين الشيوعي والليبرالي. فالنخبة الحاكمة في موسكو تخلت عن الاشتراكية، وصارت جزءاً من العالم الرأسمالي. ولا يغير هذه الحقيقة الانتقادات التي تتعرض لها من قناة الديمقراطية وحقوق الإنسان، لقمعها المعارضة وتوسل القوة لفرض إملاءاتها.
والجديد أيضاً تبلور محور مختلف في مواجهة حلف «الناتو»، تقوده روسيا والصين، وتدور في فلكه إيران وفنزويلا، بعد زوال ما كان يُعرف بـ«حلف وارسو»، وأيضاً الاحتكام للعقوبات الاقتصادية والمالية، وللحرب السيبرانية في إدارة الصراع. والأهم وجود مشروع مُبيّت لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحكم منذ عام 2000، جوهره إعادة الحياة لصورة الاتحاد السوفياتي، عبر تعزيز الوزن والدور العالميين لروسيا، الأمر الذي تجلى بتكرار سعيه لتوسيع نفوذ بلاده وسيطرتها خارج حدودها: في جورجيا عام 2008، وفي أوكرانيا نفسها عام 2014، بعد ضم جزيرة القرم، وفرض اتفاقية مينسك لدعم قوى موالية له في شرقها، وفي سوريا عام 2015، ومنذ شهور دخول قواته إلى كازاخستان لإجهاض التحركات الشعبية هناك.
صحيح أن قيادة الكرملين الحالية منزعجة من خسارة دورها كقطب عالمي، ويتملكها حنين قوي لاستعادة وزنها وموقعها العتيقين، ولا يرضيها تفرد الغرب في الهيمنة على المسرح العالمي، وصحيح أن انزعاجها الأكبر يتأتى من اقتراب حلف «الناتو» من حدودها، وتمكنه من تنفيذ مشروع الدرع الصاروخي في بلدان أوروبية، كانت حتى الأمس القريب تدور في فلكها؛ لكن الصحيح أيضاً أن تلك القيادة التي تعاطت بمرونة مع الغرب في ظل تشابك مصالحها الاقتصادية معه، وبدا أن ما يحكم سياساتها هو تنافس مدروس وتنازع آمن على حصص السيطرة والنفوذ، هي اليوم من تريد تغيير قواعد اللعبة، وتوسيع رقعة المنازعة، ودفع التنافس إلى مستوى أعلى، وربما إلى الحد الأقصى.
يصيب من يعتقد أن موسكو ما كانت لتقدم على حربها في أوكرانيا لولا التراجع المتواتر لدور واشنطن عالمياً، وأوضحه الطريقة المذلة لانسحابها من أفغانستان. ولولا ما يعانيه حلف «الناتو» من هشاشة، والاتحاد الأوروبي من ترهل وضعف، زاده ضعفاً خروج بريطانيا منه. كما يصيب من يعتقد بأن نجاح تجربة التدخل العسكري في سوريا، أغرى القيادة الروسية بجدوى اللجوء إلى القوة، لتعزيز نفوذها وفرض شروطها.
لكن؛ هل تمتلك روسيا فعلاً القدرة الاقتصادية على لعب دورها القديم، واحتلال موقعها كقطب عالمي منافس؟ وهل يصح استعادة ماضي الإمبراطورية السوفياتية، بواسطة القوة العسكرية فقط، وعبر التهديد بالسلاح النووي؟ وإلى أي مدى يمكن أن تغير موسكو موقفها، بعد أن أخفق رهانها على تفكيك العلاقات بين أوروبا وأميركا، وجاءت نتائج حربها على أوكرانيا لتعزز التعاضد بين أطراف «الناتو»؟ هل يمكن أن تربح قيادة الكرملين في أوكرانيا؟ أم ستقف مرة أخرى في موقف مشابه لما حصل سابقاً في أفغانستان، وحتى ما حصل في سوريا، حين امتلكت القدرة على الحرب والتدمير؛ لكنها لم تمتلك القدرة والإمكانات لإعادة الإعمار؟ ثم أين مصلحة حكومة موسكو وشعبها في نقض استراتيجية التعايش، والإطاحة بالترابط الواسع للمصالح الروسية الاقتصادية والمالية، الذي نشأ طوال العقود الثلاثة الماضية مع الدول الغربية؟ وأي ثمار تتوخى أن تقطفها من دفع صراعها مع الغرب وسباق التسلح إلى آخر الشوط، وقد جُرب هذا المسار طويلاً ولم يفضِ إلى نتيجة سوى التردي التنموي، وما كابده الشعب الروسي من العذاب والمعاناة؟
ثمة أنظمة استبدادية بدأت تفرك أياديها فرحاً، وتهلل لمناخات الحرب الباردة، وللعودة المحمومة إلى القطيعة وسباق التسلح، ولمنطق اللجوء إلى القوة أو التهديد بها كوسيلة للعلاقات بين الشعوب والدول، وفي مقدمها النظام الإيراني الذي لا يزال مفتوناً بلغة العنف والمكاسرة، ويتطلع لإحياء الإمبراطورية الفارسية، والذي بدل الاهتمام بأزماته الداخلية المتفاقمة، يتوغل عسكرياً أكثر فأكثر في العراق وسوريا ولبنان واليمن، متوهماً قدرة جمهوريته الإسلاموية على الهيمنة على المنطقة، وإخضاع دولها وشعوبها.
لكن؛ أياً تكن نتائج حرب روسيا على أوكرانيا، ومع تقدير حجم الألم والمعاناة التي سيتكبدها شعباهما، فإن التداعيات التي ستنجم عنها سوف تترك آثاراً بعيدة المدى على القارة الأوروبية، وعلى مناخ الصراع العالمي كله، فكم هو ظالم وقاهر للعالم أجمع ولمصير الإنسانية، فرض حرب باردة جديدة، عنوانها إحياء النظام العالمي القديم؛ عالم الإمبراطوريات وسطوتها، حتى وإن كان متعدد الأقطاب! حرب هي أكثر خطورة من سابقتها، وتنضح باحتمال انزلاق أطرافها إلى حرب ساخنة، قد تهدر ما راكمته البشرية طيلة مئات السنين.
لا نعرف إذا كان ثمة بقية أمل في الإفادة مما يحصل، لخلق رأي عام ضاغط يحاصر نوازع العنف والاستئثار والأنانية، ويحفز تعاضد القوى والفعاليات التي تتشارك القيم الإنسانية، ولها مصلحة حقيقية في عالم آمن لا ظلم فيه ولا عنف ولا تمييز، وتتطلع لبنية ودور جديدين للأمم المتحدة ومجلس أمنها، في حفظ السلم والحياة والتعايش، بعيداً عن سيطرة دول قليلة تملك حق «الفيتو» على قراراتهما، بما يخالف مبدأ المساواة في المشاركة والتمثيل والتقرير.
الشرق الأوسط
——————————
العودة إلى «الواقع» أو الحروب التي تقع فعلاً/ محمد سامي الكيال
«عادت الحرب إلى أوروبا» بناءً على هذا الإعلان خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنيه، وهو ليس بالقول الهيّن، لأن أحد المبررات الأيديولوجية الأقوى للمشروع الأوروبي المعاصر كان، ضرورة إزالة الحدود وتوحيد العملة وربط الاقتصاد بين الأوروبيين، كي لا يعودوا إلى أزمنة الحروب البغيضة، خاصة أن الحربين العالميتين، كانتا بشكل من الأشكال تحملان طابع الحروب الأوروبية. الأسوأ أن أحد أسباب اندلاع الحرب الأوكرانية كان محاولة توسيع المشروع الأوروبي، أو حتى تضخيم «الغرب» نفسه، ليصل إلى تخوم روسيا التاريخية. ماكرون تجرّأ إذن على التلميح إلى نهاية المشروع، الذي لعبت بلاده فيه دوماً دوراً محورياً.
لكن أي حرب عادت إلى أوروبا؟ سبق لكثير من المفكرين، خاصة المحسوبين على المدارس المختلفة لما يسمى «بعد الحداثة» الحديث عن تغيّر أساسي في طبيعة الحروب المعاصرة. أنطونيو نيغري ومايكل هاردت مثلاً، في كتابهما «الإمبراطورية» أكدا أن الحروب في إمبراطورية العولمة تخاض على شكل عمليات بوليسية مستمرة، تشنها تحالفات من الدول القوية على البلدان الأضعف. وكأنها محاولات لضبط الأمن الداخلي، وتأمين استمرار تدفقات السلع والأموال والمعلومات، في كيان عالمي موحّد دون مركز صلب. وبالفعل كان هذا يبدو صحيحاً في حالة «الحرب على الإرهاب» أو التدخلات في دول فاشلة و»مارقة» مثل العراق ومالي.
من جهته تحدث جان بودريار عن أن الحروب المعاصرة لا تقع فعلاً، ليس لأن العنف والقتل لا يحدثان، بل لأن الصورة المقدّمة عن الحرب لم تعد تحيل إلى واقع ونتائج فعلية صلبة، بقدر ما تقدم واقعاً فائقاً Hyperreality، أي محاكاة Simulation مؤسسة على علامات تتضمن بذاتها الاستجابة ورد الفعل المتوقع منها، ومجموعة من الإشارات المستنسخة دون أصل، قيمتها ودلالتها تنبع من موقعها في نظام العلامات المتداولة، وليس من صدقية دلالتها على الوقائع. هكذا يتابع البشر الحروب المعاصرة على وسائل الإعلام وكأنها مباراة كرة قدم.
إلا أن الحرب الأوكرانية لا تشبه كثيراً مباريات كرة القدم، رغم كل الصور المقدّمة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، التي تحاول تلميع أحد أطراف الصراع، أو تأسيس موجة تضامن عالمي عارمة معه. هنالك وقائع وعمليات عسكرية وصدامات دولية وقومية، وتهديدات فعلية للأمن والسلام العالميين، تفيض وتتفلّت دائماً عن الصورة الإعلامية للواقع الفائق، لدرجة يبدو فيها أن نمط الحروب الكلاسيكية قد عاد ليحتل المشهد. هل انتهى إذن عهد الحروب «بعد الحديثة» المنضبطة ضمن نطاق جغرافي معين، والقابلة للتقديم ضمن محاكاة من العلامات البرّاقة المُسيطر عليها بسهولة؟ وهل تُنبئ عودة الحروب إلى أوروبا، التي اندلعت هذه المرة على الطريقة الروسية، بعودة ظروف بائدة، اتسمت بثقلها وقبحها؟ وما نتائج هذا على إدراكنا المعاصر لمفهوم «الواقع» نفسه؟
عصرنة عتيقة
نظرة إلى أهم القضايا المعاصرة، قد تُظهر المحاكاة السائدة للواقع طيلة السنوات الماضية أشبه بمزحة سمجة: معظم الأنباء تتكلم عن وباء عالمي، مشاكل خطوط الغاز وغيره من موارد الطاقة، حركة الناقلات البحرية العملاقة، أوضاع المعامل والعمال المنتجين للسلع المادية حول العالم، المسائل القومية العالقة منذ القرن التاسع عشر، مناطق النفوذ الحيوي للدول. أليست هذه هي القضايا نفسها، التي لطالما حرّكت العالم طيلة القرون الماضية، وكانت من أهم أسباب الحروب ضمن أوروبا؟
لا يتعلّق الأمر بإظهار مدى تسرّع بعض المثقفين الغربيين «بعد الحداثيين» وانفصالهم عن الواقع، لدى حديثهم عن شرط جديد غيّر النظرة إلى العالم، فحتى سياسي متمرّس، مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، تحدث في «عقيدته» عن مستقبل ما، لم تعد تعنيه الأيديولوجيات القديمة، مثل القومية والجماعة والدين، بل يهتم أساساً بالتفوق التكنولوجي والاقتصادي، والقدرة على الابتكار والانفتاح على الآخر، ورفع الإمكانيات التنافسية للدول والأفراد، في عالم بات موحّداً أكثر من أي عصر مضى. ولذلك رأى أن الاهتمام الأمريكي يجب أن ينصبّ على أقاليم من العالم أدركت هذا بوضوح، مثل جنوب شرق آسيا، وليس على مناطق ما زالت تعيش في الماضي، مثل العالم العربي وروسيا.
لا يبدو أن العالم اليوم يجاري عقيدة أوباما، ولا يشبه سوقاً مفتوحة، تعطي المجتهدين والأذكياء المكاسب التي يستحقونها. ما اعتُبر أوهاماً تنتمي لعصر مضى يطغى اليوم على عالمنا بقوة، لدرجة أنه يحدد حياة كثير من البشر، ليس فقط الذين يعيشون في مناطق الحروب التي «لا تقع» بل أيضاً في الدول الأكثر اندماجاً في منظومة الابتكار و»التدفقات الحرة». يتعرّض البشر في أوروبا الغربية والولايات المتحدة اليوم أكثر فأكثر لخطر الإفقار والحروب والأوبئة العالمية، التي لم تكن بالنسبة لهم سابقاً أكثر من أخبار على شاشات تلفزيوناتهم وهواتفهم الذكية، ولا تستدعي إلا بعض التضامن الأخلاقي السهل والمجاني.
بهذا المعنى يبدو أن كل دعوات العصرنة، التي ادعت أن الروايات الكبرى قد سقطت، لحساب هموم «فئات جديدة» تتسم بفردانيتها وحساسيتها الذاتية، قد باتت هي العتيقة نوعاً ما. وربما يكون أكثر اتفاقاً مع «روح العصر» البحث عن منظورات جديدة، تستوعب قول من يُعرّفون أنفسهم بصورة مغايرة لما هو معياري من منظور الأيديولوجيا الليبرالية المعاصرة، فربما يكون هذا هو «التنوّع» الفعلي، وليس فردنة كل أشكال الذاتية، وإعادة إدماجها في منظومة ذات خطاب وتوجه أحادي.
يمكن القول، للأمانة، إن الأيديولوجيا الليبرالية الحالية، في صيغها الأكثر عمقاً، توقعت نزعات «غير عقلانية للاعتراف» حسب تعبير المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، قد تهدد استقرار المنظومة الحالية، مثل نزعات التطرف الديني والقومي والأيديولوجي، لكن الوقائع الأخيرة، التي يشهدها عالمنا، لا تتعلق بدعوات هامشية، تُبرز رأسها في فترات متقطعة، ويمكن قمعها أو تطويقها بحكمة، بل يبدو أن النزعة اللاعقلانية الفعلية هي تصور عالم قد تجاوز كل مكامن الصراع الرئيسية فيه، والأسس المادية لوجوده واستمراره، لحساب محاكاة، ظهر أنها ليست أكثر من أيديولوجيا قصيرة العمر وضعيفة الفعالية، إذا قارناها بالأيديولوجيات الكبرى في العصر الحديث.
مدن بلا سبب
الحديث عن تقادم مفهومنا عن العصرنة يقود للتفكير بالفئات، التي اعتبرت دوماً ممثلة لـ»المستقبل» وغالباً ما تنحدر من سكان المدن الكوزموبوليتية الكبرى، القادرين على إبداء أكبر قدر من المرونة، سواء في شروط عملهم، أو استقرارهم أو حياتهم الاجتماعية. ويعانون دائماً من مدى جهل غيرهم من الفئات، وإمكانية انجرارها لأفكار وتصورات غير عقلانية. ما يجعلهم مضطرين للمشاركة في معارك كثيرة حفاظاً على الوضع القائم، تكون مساهمتهم الأبرز فيها إظهار مدى وعيهم وأخلاقيتهم.
تستهدف حملات صناعة التضامن هذه الفئات دوماً، فسواء في الاحتجاجات المعادية لحكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو المواقف المؤيدة للإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا، أو التضامن الحالي مع أوكرانيا، يصبح الاصطفاف ضمن موقف موحّد، لا يقبل أي نوع من التمايز والاختلاف، معياراً لمدى صلاحية الفرد لأن يكون جزءاً من الصورة العامة المتداولة. بهذا المعنى تندمج الذوات المفردنة في محاكاة شاملة، لا تهتم كثيراً بإحالاتها إلى تعقيدات الواقع، بقدر اندراجها في منظومة تلقي وإصدار العلامات الخاوية من الدلالة، المقبولة والمصادق عليها.
تساءل عدد من المفكرين في ما مضى عن طبيعة المدن المعاصرة: لماذا يعيش فيها كل هؤلاء البشر، دون أن تجمعهم روابط اجتماعية أو مهنية أو سياسية متينة؟ ربما كانت مراكز تلك المدن، وجمهورها المتجاور بلا سبب، غير قادرة لوحدها على تكثيف الشرط الإنساني في عالمنا، أو حتى فرض هيمنتها بشكل حاسم، ولذلك يصطدم سكانها «الواعون» دوماً بكثير من أنماط الحياة الأخرى، التي يعتبرونها جاهلة وغير أخلاقية. وهم الآن يجدون أنفسهم وسط حروب وأزمات تؤثّر في حياتهم، لكنها تفلت من وعيهم السليم.
حرب أيديولوجية
قد يبدو لهذا أن الحرب الأوكرانية، مثل أي حرب مهمة في التاريخ، لها جانبها الأيديولوجي الحاسم: إذا نجح الغرب في التصدي للحملة الروسية، فسينتعش منطق المحاكاة، ونغرق في صور وعلامات برّاقة عن انتصار «إرادة التغيير» لدى الأوكرانيين؛ وإن تمكنت روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، فقد يتلقى النموذج الليبرالي، بنظرته عن الذات والعالم، ضربة كبيرة، ربما تغيّر مفاهيمنا عن الواقع. إلا أن الأمر لا يمكن اختزاله بهذه الثنائية الحاسمة، فعودة الحرب إلى أوروبا قد تكون علامة لا راد لها على انهيار المشاريع السياسية القائمة، ومآزق الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، المنتجة بنيوياً للأزمات. وبالتالي فإن تعطّل منظومة المحاكاة الأيديولوجية السائدة لن يتم إصلاحه حتى بانتصار غربي في أوكرانيا، وستجد المنظورات المغايرة والمتعددة للواقع دائماً طرقها الخاصة للبروز والتعبير عن نفسها، في سياق حروب واضطرابات أخرى مقبلة.
كاتب سوري
القدس العربي
—————————
شجرة أوكرانيا وغابة الجوار الأوروبي/ وضاح شرارة
على خلاف الخط الملحمي العربي، و”التغريبة” علمٌ عليه، يَمَّمَت الفتوح الجرمانية، والألمانية جزء منها، وجهها إلى الشرق. و”التشريق” هو شعار الحملات “القبلية” الجرمانية من السلطان أوتون الأول (912-972)، وفرسان التيتون إلى “بليتزغريغ” (الاجتياح الصاعق) أدولف هتلر في صيف 1941.
ويردّ فلاديمير بوتين، اليوم، الصاع النازي والألماني صاعاً روسياً معكوساً. فتهاجم قوّاته غرب روسيا القريب، أوكرانيا. ويمثِّل الرئيس الروسي على “الغرب” كله، الرأس المتقدّم من “أوراسيا” منظّره الاستراتيجي ألكسندر دوغين، بأوكرانيا الغربية.
ويعلل اجتياحه الصاعق، وسعيه المعلن في تدمير القوات الأوكرانية وتقويض أبنية دولتها الوطنية، بذريعتين متناقضتين ومتدافعتين: 1) استعادة الأرض الأوكرانية “الحبيبة” إلى حضن الأرض الأم، “عموم الروسيا”، على ما كان العثمانيون يكتبون، وتحريرها من الوباءَيْن الدخيلين، الديمقراطية الليبرالية والنازية. 2) “معالجة” ميول الشعب الأوكراني الأوروبية، منذ إعلانه الاستقلال في 1992 في استفتاء اقترع فوق 90 في المئة من الأوكرانيين فيه بـ”نعم”، وإدراجه في دستوره انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هدفين ثابتين.
العدوى الغربية
فأوكرانيا، على هذا، جزء أصيل و”سليب” من الوطن الروسي الكبير، ودولة دخيلة على النظام السياسي والأمني الإمبراطوري الذي خلف السلطنة السوفياتية الراحلة. وفي كلا الحالين، الأصالة والدخالة، تنتسب أوكرانيا إلى الغرب الأوروبي على وجهين مقلقين، يحرّكان نازعين عدوانيين إما صوب الداخل (الاقتطاع والاستعادة)، وإما صوب الخارج (التصدّي والمدافعة).
وأوكرانيا، أو “الروس الكييفية”- على ما كان اسمها بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر الميلاديين، قبل استواء “الموسكوب” سلطنة أو إمارة عريضة تضم “الأقيال” أو الأشراف المحليين- مرآة تنازع روسي قديم ومعلّق بين القطب “السلافي” الفريد والخاص، وبين القطب الأوروبي، “الخارجي”، العقلاني والفردي والمادي، على قول أصحاب الأصالة والفرادة السلافيّتيْن، والأوراسيويّتيْن اليوم. وهذا شأن دول ومجتمعات حزام الصقيع على حدود روسيا الغربية، فنلندا والسويد وجمهوريات البلطيق الثلاث وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا، إلى رومانيا والمجر ومولدافيا، على قدر أقل.
والترجُّح بين الضم والاستيعاب ومدّ النفوذ القسري وبين التحصُّن بهذه الدول من العدوى الغربية وتشييد الأسوار الواقية منها، يكاد يكون سمة فارقة وثابتة، حديثة، من سمات تعقيد العلاقات الروسية-الأوروبية، وأزمة هذه العلاقات المزمنة. فقامت “عموم الروسيا”، وهو اسم على مسمى، على التوسُّع غرباً وجنوباً وشرقاً. فامتدت من أقصى الشرق الياباني والصيني إلى شرق أوروبا وبينهما آسيا الوسطى. واقتطعت أراضي وأقاليم كثيرة من الإمبراطوريات التي تسوّرها: من فارس والسلطنة العثمانية واليابان والصين والسهوب القطبية، ومن السويد وليتوانيا والبلدان السكندنافية المتاخمة.
وضَوَت “عموم الروسيا” عدداً كبيراً من الشعوب والأقوام والأنظمة السياسية والأبنية الاجتماعية والثقافات المختلفة والمتباعدة. وصَهْرُ هذه الزركشة في إطار متصل ومتماسك يفوق قدرات دولة وطنية بين أقوامها وطبقاتها وبلادها أو مناطقها لحمة سياسية قوية، فكيف بطاقة دولة استبدادية و”عمودية”؟
والولايات المتحدة الأميركية هي المثال النقيض على مشكلة الصهر الروسية. وكان ابتكار “الوطنية الدستورية”- أي تعريف الرابطة السياسية الداخلية بإجراءات حقوقية وقانونية عامة ومشتركة، وبترتيب العلاقات بين السلطات والهيئات والمراتب على الموازنة بينها- حلاً تقريبياً جمع بين المركزية التنفيذية وبين الاستقلال المحلي والثقافي. وتجافي “الوطنية الدستورية” هذه الأوتوقراطية القيصرية، والكليانية (الشمولية) السوفياتية، مجافاة حادة.
المعالجة بالتوسُّع
وأرست القيصرية المضطربة والمتزعزعة (سياسياً بين الأشراف واجتماعياً بين الطبقات) “السلم الأهلي” الروسي على التوسُّع، والتحصُّن من الإمبراطوريات والبلدان المتاخمة، وعلى أبنية اجتماعية قاهرة وبالية، وثقافة دينية وعرقية محافظة، ومناهضة للغرب التنويري وللإسلام العثماني معاً. وحين تحرّر شطر متعاظم من النُّخب الروسية، الاجتماعية والثقافية، من السجن القيصري، الأرثوذكسي والسلافي، حال ضيق دائرة هذه النخب، وترجّحها المعلّق والمرهق بين قطبيْ الفرادة والعمومية، وخروجها عن المشترك الروسي الشعبي والمنكفئ، حالت هذه مجتمعة دون نضوج صيغة تواصل وتفاهم ومعامَلة جامعة.
وتصوَّر “العامل الغربي” (أي التأثيرات المتفرقة الصادرة عن الغرب الجغرافي والسياسي الاجتماعي والفكري)، في صورة النزعات القومية الوطنية الاستقلالية، أو الضوابط الدستورية الليبرالية، أو الدعوات إلى المساواة… أي في صورة الباعث على الشقاق والنزاع والاختلاف والإنكار والفردية والمنافسة والسطو على الموارد والاستعمار. وخالف هذا نازعاً روسياً- وهو نازع يغلب على المجتمعات الانتقالية التي تقوم لحمتها الغالبة في حقبة ما بعد التقليد على تماسكٍ عصبي متصدّع- جميعياً، على ما تسمّيه الاجتماعيات المشتركة. والنازع الجميعي هو على الضد من النازع الفردي. واستقى الاستشراف الخلاصي الروسي مادته من معين هذه النزعة.
والاستيلاء على الغرب الجغرافي، أو على الشطر القريب منه، وراء ستارةٍ “صليبية” تنقّلت بين صيغ أخروية وطوباوية متفرقة ومتناقضة، هو الأيسر والأقرب إلى المتناول. وعلى الأخص إذا كانت الدولة المستولية لا تملك من عوامل القوة والسيطرة إلا آلة عسكرية متضخّمة، قياساً على الموارد البشرية والاقتصادية والتقنية العلمية التي تحوزها الدولة.
واختبرت روسيا القيصرية، وروسيا السوفياتية من بعدها، وجوه استعمال الأرض الروسية الشاسعة، واصطفاف بلدان الفتوح والضم حاجزاً صادّاً على طريق الفاتحين الأجانب. فحين غزا نابليون الأول الفرنسي الروسيا هذه، في 1812، وأراد تتويج حروبه القارية على قيصرها ورأس الحلف الأوروبي “الرجعي”، لجأ قائد الجيوش الروسية، ميخائيل كوتوزوف (1745- 1813)، إلى ما سمّاه الروائي الكبير ليون تولستوي، في روايته “الحرب والسلم”، “حرب قوم الشاش”، وهي صنف من الحرب يقضي بتملّص المحارِب الضعيف من الاشتباك، والتوغُّل في أراضيه العميقة، واستدراج عدوّه إلى اللحاق به. وفي 1941، غرقت الجيوش الألمانية المدرّعة في العمق الروسي “الشاشي”.
وعندما خرج النظام السوفياتي من “اشتراكية الدولة الواحدة” والمطوّقة، على خلاف “أممية النوع البشري” (النشيد الأممي) و”فيديرالية الجمهوريات الاشتراكية”، واستولى، في ختام الحرب العالمية الثانية على بلدان شرق أوروبا، وأسدل “ستاره الحديدي” على ممتلكاته الجديدة، صرف همّه إلى إنشاء حزام عميقٍ وواقٍ من الغرب. فأعمل في الدول والمجتمعات التي حرّرها، من النازية، إلى الغرب من نهر الأودير- نايس، السَّفْيَتَة Sovietization. وفرض على هذه البلدان، وهي تؤلف “الغرب المخطوف”، على قول الروائي التشيكي-الفرنسي ميلان كونديرا، قوالب النظام السوفياتي، اللينيني والستاليني.
وافتتح تخريبه الأبنية الوطنية البولندية، في 1940، غداة اقتسام بولندا مع هتلر، بقتل 20 ألف ضابط وصف ضابط في غابة قريبة من مدينة كاتين، ونسب المقتلة إلى الجيش الألماني وكذّبت الادّعاء وثيقة سوفياتية قدّمها بوريس يلتسين إلى الدولة البولندية.
حزام الجليد
عمّمت السّفْيَتَة مثالَ الحزب الشيوعي، الواحد الأحد. وأُسلم إليه “قيادة الدولة والمجتمع” (المادة الثامنة من الدستور… البعثي السوري قبل “إلغائها”). ومُلِّك وسائل الإنتاج والتوزيع. ودُمج في الدولة، وسُعي في دمجه في المجتمع. وسُلّط على المجتمع وعلى الأهالي البوليس السرّي، و”أركان” المعتقد الماركسي-اللينيني”. ولا تستقيم السَّفْيَتَة، ولا تبلغ غايتها الفعلية، وهي القيام حاجزاً صفيقاً بين غرب أوروبا وبين بيروقراطية عموم الروسيا الإمبراطورية، إلا بحماية “نومونكلاتورا” (الصفوة أو النخبة الحاكمة) هذه البيروقراطية من مجتمعاتها المغلوبة وحركاتها السياسية-الاجتماعية.
ولا سبيل إلى بلوغ ذلك، السَّفْيَتَة والحجز والحماية، إذا وسع بعض نخب هذه الدول، الغربية، المحافظة على رابطة تاريخية وطنية بمجتمعاتها وأوطانها. فالدولة الوطنية إرث أوروبي غربي، على رغم جموح الرأسمالية المفرطة، ومقدمة بناء “المجتمع الكوسموبوليتي”، العالمي والأممي، الذي كان ينبغي أن ترهص به “عصبة الأمم” غداة الحرب العالمية الأولى، و”جمعية الأمم المتحدة”، غداة الحرب العالمية الثانية. وقانون هذا المجتمع هو الاحتكام إلى هيئات حقوقية دولية، وتحكيم قانون دولي، عُرف قبل القرن التاسع عشر بـ”حق الناس”.
فاستكمل النظام السوفياتي المنتصر السَّفْيَتَة المفروضة والمعمّمة بالاجتثاث الوطني والقومي. وبادر، أول ما بادر، إلى استبعاد ممثلي حركات المقاومة الوطنية والمحلية التي نظّمت الأعمال العسكرية ضد المحتل النازي الألماني، من عودتهم إلى الداخل. وكان بعضهم، على مثال شارل ديغول الفرنسي، آثر الخروج من الأراضي الوطنية المحتلة، ولجأ إلى ضيافة دولة أوروبية قريبة، كانت بريطانيا في الأغلب، وقيادة المقاومة منها، وتلبية حاجاتها إلى التسليح والتمويل والتنسيق والاستخبار.
واستبعدت الوصاية السوفياتية المحتلة قيادات الخارج من المفاوضة على الإدارة الانتقالية، وطعنت في وطنيتها، واتهمتها بالعمالة للغرب أولاً. وعمّمت تدريجاً تهمة التعاون السابق والمشين مع المحتل النازي، بذريعة نشأة حركات نازية داخل هذه البلدان في الأعوام التي سبقت الحرب. ولم يلبث الاحتلال الجديد أن عمد إلى اغتيال بعض القيادات الصلبة، واستبق نشوء حركات وطنية مناهضة لاحتلاله، ولنهبه مصانع وطنية ومصادرته جزءاً من الأبنية التحتية.
وباء الديمقراطية
ومن آيات فضائله ونِعَمه على بلدان الحِمى الذي اقتطعه، بذريعة تحريرها من النازية، تأخيره بلداً صناعياً مثل تشيكوسلوفاكيا من المرتبة التاسعة على سلّم مراتب التصنيع و”التقدُّم”، قبل الحرب الثانية، إلى المرتبة الثلاثين بعدها. ومهّد للاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا بما سمّي “ضربة براغ”، في 1948، كناية عن دسّ وزراء حزبيين مقنّعين، يولون وزارات سيادية قبل انقلابهم وانحيازهم إلى فريق الموالين و”المُسَتَفْيِتين”.
وفي أعقاب 1947، واستحكام عقدة “التآمر اليهودي” على ستالين، وشنّه حملة اعتقالات على أطباء وممرّضين مقرّبين منه، معظمهم من اليهود، توالت محاكمات أمنية في عدد من العواصم، براغ وبودابست وفرصوفيا (وارسو) وصوفيا البلقانية، “طهّرت” صفوف الأحزاب الشيوعية الحاكمة من وجوهها الوطنية المثقفة وذات الميول والروابط الأوروبية.
ونهضت وراء المسرحيات البوليسية القاتمة، وترجيعها أصداء تاريخ آسن، قضية سياسية مركزية هي المسألة الألمانية. فألمانيا، في وسط أوروبا وقلبها، هي بؤرة المشكلات السياسية والعسكرية المتخلفة عن الحرب الهائلة، الحرب العالمية على ما يسمّيها المؤرخون، والتي ختمت حرب الثلاثين عاماً الأهلية الأوروبية، وهو الاسم الذي سمّى به شارل ديغول حقبة 1914 (بداية الحرب “الكونية” الأولى)- 1945 (خاتمة الثانية). وكبّدت ألمانيا النازية في الحرب الثانية بعد الأولى، خسائر ثقيلة في البشر والمنشآت. وأثبتت أنها مصدر أخطار مميتة، استراتيجية، على روسيا.
واستعجل الحلفاء الثلاثة (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تسليح ألمانيا الفيديرالية، الغربية، وضمها إلى حلف أنشأوه، في 1949، في مقابلة الحزام الجليدي الذي حصّن به ستالين القلعة الروسية السوفياتية. وأغضوا بعض الشيء عن ضلوع بعض أعيان النظام النازي البائد في جرائم النظام، واستعملوا هؤلاء في مهمات ووظائف أمنية واقتصادية وأخيراً سياسية.
والحق أن ما أثار حفيظة موسكو لم يكن الاستعمال الضيّق والمتحفّظ هذا، فنظام بانكو (ألمانيا الشرقية “الديمقراطية”، شأن لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم) استعاد عدداً كبيراً من النازيين السابقين في إداراته ووظائفه الفنّية ومراتبه الحزبية. فالباعث على القلق كان قبول شطر عريض من النخب الألمانية، ومن الشعب الألماني، التخلي طوعاً عن مزاعم “الطريق (الألماني) الخصوصي”، أي غير الأوروبي، إلى الحداثة. فانخرط ألمان ما بعد النازيّة في السيرورة الغربية، الديمقراطية الليبرالية، الدستورية الحقوقية والفردية. وقاموا حيال الكتلة السوفياتية، المتعسكرة والبيروقراطية، نموذجاً ومثالاً على إعمار مثمر وسريع، وعلى قدر نسبي من التوزيع المتساوي.
الحياد
كان الجوار الديمقراطي الليبرالي القريب التهديد “النووي” الفعلي الذي أيقنت البيروقراطية الحزبية والإيديولوجية البوليسية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية RDA هي موطن ستازي، البوليس الأهلي وجيشه العرمرمي من الوشاة)، منذ أيام التقسيم الأولى، بعجزها عن مجاراته والصمود بوجه مقارنتها به. فردّت على الانتفاضة العمّالية الأولى، في برلين عام 1953، بقمع قاتل، كرّرته في 1956 في بولندا، وشيّدت “جدار برلين” المجيد في 1961 تلافياً لنزيف سكانيّ مرضي، وفي 1968 جدّدت كرّة القمع في تشيكوسلوفاكيا، وفي 1981 في بولندا.
وطوال ربع قرن من السنين شنّت الأجهزة السوفياتية أعنف حملة دعائية مضلّلة على مَن سمّتهم “الثأريين الألمان”، الطبقة الحاكمة في ألمانيا الفيديرالية. وذهبت إلى تفسير التضامن الألماني مع أوروبا، وانخراط الدولة في الهيئات الأوروبية الوليدة، بالرغبة في الثأر لهزيمة النازية. واضطر رأس هذه البيروقراطية، ميخائيل غورباتشوف، في 1985، إلى استخلاص بعض دروس الهزيمة السياسية والاجتماعية والثقافية. وقبل غورباتشوف، كشّر الثلاثي القيادي السوفياتي، المهيب والهرم، ليونيد بريجنيف ويوري أندروبوف وأندري تشيرنينكو، عن أسنان الاتحاد السوفياتي الصاروخية. فنصبت صواريخ إس إس-20 و23، القصيرة المدى، على خط الانقسام الأوروبي-السوفياتي. وأخاف نصبها جمهوراً ألمانياً صدّق أن مصدر التهديد عسكري. وهو زعمٌ يردّده اليوم، حرفياً، جهاز التضليل البوتيني.
ولوّح القادة السوفيات، من ستالين إلى غورباتشوف نفسه وربما إلى بوريس يلتسين، بتوحيد ألمانيا، والنزول عن شطرها السوفياتي، لقاء تحييدها، أي خروجها من الرابطة الغربية. وقَسَمَ هذا التلويح الأوروبيين والألمان. وبينما يهدد فلاديمير بوتين بنُظُم أسلحة جديدة، فرط صوتية (أسرع من الصوت بسبع مرات) ونووية، يفترض فيها أن تلغي الأخطار الناجمة عن اقتراب بنية حلف الأطلسي التحتية من الحدود الروسية، يتعلّل دعاة الرجل بعلل ستالين وخروتشوف وبريجنيف، إلخ.
رصيف 22
——————————
الدفاع الأوروبي بين جيليْن/ بشير البكر
قام الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، بآخر تجربة نووية فرنسية في يناير/ كانون الثاني 1996، بعد ستة أشهر من وصوله إلى الرئاسة، وواجه ردود فعل محلية ودولية واسعة ضد المسألة، من منطلق أن دور الأسلحة النووية انتهى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وردّ شيراك على منتقديه أن الاتحاد السوفييتي انتهى لكن سلاحه النووي لا يزال موجودا، ولا نستطيع أن نجزم أنه لن يدخل الكرملين حاكمٌ روسيٌّ، يلوح بهذه الورقة من جديد. وصدقت رؤيا شيراك بعد أكثر من ربع قرن، وها هو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يضع أوروبا أمام هذا الكابوس الكارثي، الذي حسبت أنها طوت صفحته بنهاية الحرب العالمية الثانية. وصرّح وزير خارجيته، سيرغي لافروف، بأن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية.
يختلف جيل القادة الأوروبيين الذي عاش الحرب العالمية الثانية، في النظر إلى المخاطر عن الأجيال اللاحقة. شيراك وأسلافه، فرانسوا ميتران، فاليري جيسكار ديستان، وجورج بومبيدو، رفضوا الخضوع للضغوط الداخلية والخارجية لوقف تطوير الأسلحة النووية التي يقف وراءها الجنرال شارل ديغول، الذي أنتج أول قنبلة ذرية في عام 1960، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بـ 15 عاما. وكان الهدف في ذلك الحين امتلاك سلاح ردعٍ يحمي فرنسا من تجربة الوقوع تحت الاحتلال، ولم يكن الخوف من ألمانيا التي واجهت فرنسا في الحربين، الأولى والثانية، واحتلت عاصمتها باريس في الثانية، وإنما من القوى التي تمتلك السلاح النووي، مثل الاتحاد السوفييتي، وحتى بريطانيا التي سبقت فرنسا إلى القنبلة بسبعة أعوام.
الرؤساء الفرنسيون، نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند، وإيمانويل ماكرون، امتلكوا نظرة مختلفة عن جيل الرؤساء السابقين في التعاطي مع سياسات الدفاع. وفي حين أن الجيل القديم كان يتعامل مع الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما مصدري تهديد دائم، غرق الجيل الجديد في بحر نظرية الحرب على الإرهاب، واعتبرها المصدر الأساسي للخطر، وبنى استراتيجيات وسياسات دفاعية على هذا الأساس. ولذا جرى إهمال الجيوش التقليدية لصالح قوات لمكافحة الإرهاب وأجهزتها. وأطلق ماكرون عام 2019 نظرية تقول إن الخطر على أوروبا يأتي من “الإرهاب الجهادي” القادم من الجنوب، وليس من روسيا، رغم أن فلاديمير بوتين كان قد خاض حربا في جورجيا عام 2008، واقتطع جزءا من أراضيها، وضمّ شبه جزيرة القرم التي تعود إلى سيادة أوكرانيا في عام 2014. وحتى أيام معدودة من مغامرة بوتين الجديدة بغزو أوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي (فبراير/ شباط)، لم يكن ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز وغالبية قادة أوروبا يعتقدون أن الرئيس الروسي يمكن أن يحاول إخضاع أوكرانيا بالقوة، ويجتاحها بجيوشه، وهي دولة جارة ذات سيادة تحكمُها سلطةٌ منتخبةٌ في عام 2019، وحين تم فرض عقوبات ضد روسيا وتحرّكت أوروبا لمساندة أوكرانيا، هدّدها بوتين بالصواريخ البالستية الحاملة رؤوسا نووية.
وضع جديد في أوروبا يتمثل بسقوط سياسة الحوار مع روسيا بدلا من الردع، وبدأت النخب الأوروبية الحاكمة تحسّ بالرياح الباردة القادمة من روسيا، في حين أن النظام الدفاعي الأوروبي الحالي غير قادر على مواجهة المخاطر الآتية من روسيا. وهناك قناعةٌ لا يرقى إليها شك في أوساط البلدان المحيطة بأوكرانيا، بأن الحرب لن تقف عند حدود هذا البلد وسوف تتعدّاها. وهذا ما يفسّر التحرّك الأوروبي السريع لمساعدة أوكرانيا عسكريا، وفرض عقوباتٍ غير مسبوقة على روسيا، هدفها إلحاق أضرار بالاقتصاد الذي يموّل حروب بوتين. وبالتالي، فإن أوكرانيا هي معركة أوروبا، سواء قبلت عضويتها في الاتحاد الأوروبي أم لم تقبل. وسيتعيّن على أوروبا قبل الولايات المتحدة أن تضع ثقلها في هذه الحرب، من أجل منع الغزو الروسي من تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة المدى.
العربي الجديد
——————————
أجيال السلاح الروسي: اختبار في سوريا وتحديث في أوكرانيا/ صبحي حديدي
في تموز (يوليو) 2021 زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مصنعاً للحوّامات في روستفيرتول، وتفاخر بأنّ الجيش الروسي اختبر في سوريا أكثر من 320 نمطاً من الأسلحة، وقال بالحرف: “إحدى هذه الحوّامات التي ترونها اليوم هي نتاج العملية السورية”. قبله، ولكن في حزيران (يونيو) 2018، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سبق شويغو في تثمين الفوائد التي قدّمها الميدان السوري على سبيل اختبار الأسلحة الروسية: فرصة “لا تُقدّر بثمن”، قال بوتين، مشدداً على أنّ استخدام السلاح في ساحات القتال الفعلية لا يعادل أيّ طراز من التدريبات أو المناورات. وقبل أيام من انطلاق الزحف العسكري الروسي نحو عمق أوكرانيا، أشرف شويغو على مناورات روسية بحرية في المياه السورية، وبعض القطع المشاركة توجّب أن تتحرّك بالفعل نحو البحر الأسود للانخراط في العمليات القتالية الفعلية ضدّ أوكرانيا.
هنالك اعتبارات، لا عدّ لها ولا حصر ربما، تؤكد الفوارق الحاسمة بين التدخل العسكري الروسي في سوريا، والاجتياح العسكري الروسي الراهن في أوكرانيا؛ وتلك اعتبارات تتجاوز الأبعاد التاريخية والجيو-سياسية والأمنية والثقافية، ثمّ النفسية والذاتية عند بوتين شخصياً، إلى الفوارق بين شخص الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي (على علاته، غير القليلة كما يتوجب القول)؛ ومجرم الحرب الصغير التابع بشار الأسد، وبطانة الاستبداد والفساد، في سوريا. غير أنّ واحداً من جوانب التقاطع، أو التطابق بدرجة عالية، هي حكاية اختبار الأسلحة الروسية الحديثة، عالية التكنولوجيا، “فوق الصوتية” كما في الرطانة العسكرية، المحاذية لأسلحة التدمير الشامل في أجيالها الكلاسيكية والمحدّثة؛ والتي، على وجه الدقة، كانت وتظل موضوعاً للتفاخر لدى كبار الجنرالات الروس، وعند بوتين شخصياً.
وليس الأمر أنّ الجيش الروسي، في عهد بوريس يلتسين قبل بوتين، لم يمتلك الفرصة أو الميادين لاختبار أجيال السلاح الروسي الجديدة فعلياً؛ فقد كانت تجارب شيشنيا وجورجيا وشبه جزيرة القرم قد تكفلت ببعض هوامش التجريب، وأسفرت عن إدخال بعض التغييرات، التي ظلت مع ذلك محدودة. فارق الميدان السوري تمثّل، أوّلاً، في ضعف الخصم أو حتى عدم وجوده عملياً أحياناً؛ الأمر الذي أتاح المزج بين اشتراطات الاستخدام القتالي الميداني والنيران الحيّة، ومقتضيات الاختبار الآمن الذي يقارب المناورة في بعض الحالات. صحيح أنّ مقاتلات تركية (إف-15 أمريكية الصنع) تمكنت من إسقاط مقاتلة سوخوي-24 روسية في سماء سوريا، خريف 2015 بعد أسابيع قليلة على التدخل الروسي، إلا أنّ الواقعة لم تندرج في سياق اختبار أداء الطائرة الروسية، كما أنّ هذه المقاتلة لم تكن في عداد الصنوف الجديدة الذي عكف الجيش الروسي على تجريبها في سوريا.
جانب ثانٍ يسبغ أهمية خاصة على حقول الاختبار السورية، لعلها استثنائية وفريدة أصلاً، هو أنّ الأسلحة الروسية التي تُستخدم في سوريا (في سماء الساحل تحديداً، ومناطق حمص وحلب وإدلب بصفة خاصة) إنما تجرّبها موسكو تحت احتماليات الاحتكاك مع صنوف الأسلحة الأطلسية المختلفة، مباشرة عبر التحالف أو الجيش التركي في الشمال، من جهة أولى؛ والأسلحة الإيرانية، الصاروخية والمضادّة للدروع أوّلاً، من جهة ثانية؛ وكذلك المقاتلات الإسرائيلية التي تقوم بعمليات قصف شبه منتظمة في مختلف المناطق السورية، من جهة ثالثة. هذه حال تمنح سيرورات الاختبار الروسية قيمة خاصة يندر أن تتوفر في الصيغة الميدانية المباشرة، لأنها أيضاً تدور في إطار ثلاثة أصناف من ترجيح المواجهة: 1) مع خصم (متَّفَق معه ضمناً) هو التحالف والسلاح الأطلسي؛ و2) شريك/ صديق ميدانياً (لا تغيب عنه المنافسة وبعض الخلاف)، هو السلاح الإيراني؛ و3) حليف غير مباشر (وأطلسي غير معلَن رسمياً)، هو السلاح الإسرائيلي.
وحال التشابك هذه، التي وحّدت سلسلة من المصالح المتطابقة تحت مظلات عجيبة من الاختلافات الشكلية والسياسية والتحالفية، أتاحت للولايات المتحدة والحلف الأطلسي وغالبية الحكومات الغربية أن تسكت عن اختبارات أكثر من 320 سلاحاً روسياً جديداً، جرى تجريبها تباعاً في سوريا منذ ابتداء التدخل الروسي خريف 2015. وقد يكون صحيحاً أنّ السكوت ذاك اقترن، عند مَن امتلك الوسيلة، بمراقبة لصيقة لنتائج التشغيل الروسي لجديد هذه الحوّامة أو تلك الطائرة المسيّرة؛ لكنّ أياً من المراقبين، عن كثب أو عن بُعد، لم يتخذ من إجراءات الحدّ الأدنى بصدد واحد من أقذر الخيارات في الصناعات العسكرية: التجريب الحيّ على البشر المدنيين، في المشافي والمدارس والمخابز والأسواق الشعبية. حينذاك سكتت واشنطن وبروكسيل ولندن وباريس وبرلين، هذه العواصم إياها التي تجأر اليوم بالصراخ (وبعض النحيب كذلك!) احتجاجاً على الاجتياح الروسي في أوكرانيا، وعلى… تطبيق ما اختُبر ضدّ أطفال ونساء وشيوخ سوريا، ولكن في كييف وخاركيف وماريوبول…
وخلال دورة 2007 لمؤتمر ميونخ الشهير حول قضايا الأمن والدفاع، أصاخ المندوبون السمع، والكثير منهم صفّق، خلال خطبة بوتين التي لا تقلّ شهرة؛ ومن غرائب الصدف أنّ ذكراها الـ15 تمرّ هذه الأيام تحديداً، على وقع قذائف الجيش الروسي وعذابات الشعب الأوكراني. وكيف يُنسى تركيز الرئيس الروسي على القول بأنّ مشكلة الأمن الدولي أقرب صلة إلى واقع الاقتصاد العالمي ومشكلات الفقر والحوار بين الحضارات، منها إلى الاستقرار السياسي أو العسكري؛ أو الامتناع عن اقتباس لينين أو ستالين أو الإمبراطورة كاترين، كما فعل مؤخراً في خطبة الزحف على أوكرانيا، والعودة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق فرنكلين روزفلت، بصدد الحرب العالمية الثانية: “أينما يُنتهك السلام، فإنّ العالم كلّه يقع تحت التهديد”. الغرب صفّق، لكنه تنبّه أيضاً إلى المرارة الدفينة في رثاء بوتين للاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، وهجاء تمدّد الحلف الأطلسي نحو رومانيا وبلغاريا، والتلويح بأنّ الآلة العسكرية الروسية في تطوّر حثيث.
ولقد عقد بوتين اجتماعاً دراماتيكياً مع أركان القيادة العسكرية الروسية، وأبلغ العالم بأنّ روسيا سوف تنشر في الأعوام القليلة القادمة أنظمة صواريخ نووية جديدة متفوّقة على كلّ ما تمتلكه القوى النووية الأخرى في العالم أجمع. وفي تصريحات ساخنة قال إنّ بلاده لن تكتفي بالأبحاث النووية والاختبارات الناجحة للأنظمة الجديدة، بل هي ستتسلّح بها فعلياً خلال السنوات القليلة القادمة: “أنا واثق أنّ هذه التطوّرات والأنظمة غير متوفرة لدى الدول النووية الأخرى، ولن تكون متوفرة في المستقبل القريب”. وفي الخلفية كان ثمة تصريح جورج روبرتسون، الأمين العام الأسبق للأطلسي، بأنّ الحلف بات يضمّ دولاً تمتدّ مساحتها من فانكوفر في كندا إلى فلاديفوستوك شرق روسيا. وفي خلفية ثالثة كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن قد اعتبر أنّ الحرب الباردة انتهت الآن فقط، مع صدور “إعلان روما” الذي تضمّن تشكيل المنتدى الأمني الجديد، بعضوية دول حلف شمال الأطلسي الـ19، بالإضافة إلى روسيا: أيّ أنها لم تنتهِ على يد جورج بوش الأب والرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، بل جورج بوش الابن ونظيره فلاديمير بوتين!
وما يشعله بوتين اليوم في أوكرانيا قد لا يكون جولة أولى في الحرب الباردة الثانية، لكنه ليس البتة بعيداً عن التطبيق العملي لحذافير عديدة في خطبة ميونخ 2007، لجهة كسر نظام القطب الواحد واستئناف الإمبراطورية الروسية بوسائل الغزو العسكرية ذاتها التي انتبذها بوتين قبل 15 سنة؛ مع فارق حاسم: لقد اختبر في سوريا، وها أنه اليوم يحدّث ويستحدث في أوكرانيا… ليس أقل”!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
————————-
الاسد عندما يخسر الغطاء الروسي..والايراني/ ساطع نور الدين
لم تكن موفقةٌ أبداً المقارنات التي أجريت طوال الاسبوع الماضي، بين عذاب سوريا وبين شقاء أوكرانيا، نتيجة استهدافهما بالقوة العسكرية الروسية المفرطة، والطموحات السياسية الروسية الخيالية. ولم تكن لافتة، ولا حتى لائقة، تلك المنافسة المفتعلة ما بين الشعبين السوري والاوكراني على موقع الضحية ورتبتها.. التي أوحت بأن المعارضين السوريين الذين إنتهزوا المناسبة لكي يستدرّوا عطف الغرب، وتدخله، لم يتعلموا الدرس القاتل للثورة السورية.
صحيح أن الاقدار هي التي وضعت اوكرانيا وسوريا معا أمام أعين زعيم روسي يكره الثورات الشعبية أينما جرت، ويعتبرها تآمراً أميركياً أو غربياً على بلاده، ويعتقد ان وظيفته السياسية هي قيادة أو رعاية الثورات المضادة أينما كانت.. لكن الوحي الاوكراني كان حاسماً في تشكيل موقفه وتحديد سلوكه، أكثر بكثير من الوحي السوري الذي لا يزال يبدو وكأنه خط الدفاع الخلفي عن التوسع الروسي في أوكرانيا، حيث إختبرت وستظل تختبر فكرة الامبراطورية الروسية وفرصتها.
لسوريا أهميتها الخاصة، التي لا تقاس بقيمة الدولة ولا بقوة الجيش ولا بحجم الاقتصاد، وهي كلها معايير هزيلة إذا ما قورنت بالحقائق والارقام في اوكرانيا.. الأهم هو أن سوريا تحسب كهدية حصلت عليها روسيا، من الاميركيين والاسرائيليين والغرب عموما، في خريف العام 2015، تحديداً بعد أشهر فقط على نجاح الثورة البرتقالية الاوكرانية التي إعتبرها الكرملين يومها أخطر توغل غربي في العمق الاستراتيجي لروسيا،وأقرب نقطة يمكن أن يصل اليها الغرب في طريقه الى موسكو. كان يفترض ان تكون سوريا بمثابة تعويض، أو ربما وسيلة لتهدئة روع الرئيس فلاديمير بوتين، ودليلاً على حسن النية، وعلى براءة الغرب من التحريض على ثورة شعبية ديموقراطية في كييف غير البعيدة أبداً عن العاصمة الروسية.
من هذه الزاوية، يمكن أن تبدأ المقارنة، لكي يستقيم النظر الى الغزو الروسي الحالي لاوكرانيا، ويتضح أن سوريا تبدو وكانها خارج المسار السياسي والعسكري الروسي. هي وديعة مهمة، لكنها لا تحمي الخاصرة الروسية، المهددة اليوم بحرب إستنزاف في شوارع المدن الاوكرانية، كما أن نظامها الذي أحيته الآلة العسكرية الروسية لا يقارن، حسب الكرملين، بأهمية نظام الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاتشينكو الذي لا يواجه أي خطر داخلي.
ومن هذه الزاوية أيضا، يمكن تسجيل الفوارق المهمة بين الغزو الروسي الراهن للاراضي الاوكرانية بمختلف الاسلحة الجوية والبرية والبحرية، التي تحيل مدن اوكرانيا الى خراب، وبين الاجتياح الروسي لسوريا، الذي ساد في الجو، وزاد في أعداد النازحين السوريين، ودمّر البنى المدنية السورية، لكنه لا يزال يجد صعوبة في احتكار السيادة على الارض السورية في مواجهة إيران وقواتها وأدواتها، في الوسط والجنوب، أو في إدعاء السيادة على الارض السورية التي تخترقها تركيا وشبكاتها في الشمال.
وبهذا المعنى، يبدو الغزو اليوم، وكأنه نتاج فشل روسي في احتواء التهديد الآتي من العمق الاوكراني، وهو سيؤدي حتماً الى كارثة روسية جديدة، نتيجة العقوبات الغربية الخانقة، ونتيجة المقاومة الاوكرانية الرسمية والشعبية، التي أذهلت العالم كله، قبل ان تصبح ظاهرة استثنائية تديرها علنا حكومات دول أوروبا الغربية وتمدها بالسلاح والعتاد، بوصفها حركة تحرير وطنية، تحمي عواصم الغرب من الخطر الروسي. من تلك المقاومة الاوكرانية الجريئة، المستندة الى وطنية أوكرانية أكثر جرأة يفترض ان يفتح الحساب السوري مع الذات: لماذا لم تنتج التجربة السورية مقاومة شعبية مشابهة؟ ولماذا يتكرر الحديث عن الخذلان الاميركي للسوريين، من دون الانتباه الى أنه إذا ما قررت واشنطن التدخل فعلا في سوريا فإنها ستتدخل لحماية النظام لا لإسقاطه او حتى تغيير سلوكه..
سؤال سوري وحيد يصلح أن يكون أساس أي مقارنة مع الحدث الاوكراني: هل يمكن أن يصمد نظام بشار الاسد إذا ما ازداد الضغط على روسيا؟ الجواب الفوري، هو: نعم، لأنه صامدٌ بفضل إيران أكثر مما هو باقٍ بفضل روسيا. قد يفقد قدرته على التلاعب بالحليفين الروسي والايراني، كما فعل بنجاح أكيد، طوال السنوات القليلة الماضية، لكن تعرضه للتهديد، يحتاج الى ما هو أكثر من صفقة أميركية إيرانية.. تلوح الآن في الافق.
المدن
—————————
ثمن التساهل مع بوتين في سوريا/ خيرالله خيرالله
نعم أوروبا مختلفة والتهديد الروسي لها انطلاقا من أوكرانيا يأخذ بعدا مختلفا لكنّ المنطق يقول إنّ العالم واحد وإنّ المشكلة مع بوتين بدأت عندما تساهل معه هذا العالم في سوريا.
يقول المنطق إن العالم سيتفادى حربا عالميّة ثالثة تتسبب بها حرب أوكرانيا التي تتعرّض لاجتياح روسي. على الرغم من أنّ العالم لن يشهد، على الأرجح، مثل هذه الحرب العالميّة، لكنّه سيصبح مختلفا في ظلّ عودة نظرية توازن الرعب الذي تحكمت به منذ انتهاء الحرب العالميّة الثانية في العام 1945… حتّى انهيار الاتحاد السوفياتي رسميا أوائل العام 1992.
لن يكون عالم ما بعد أزمة أوكرانيا وحربها مثل عالم ما قبل العمليّة العسكريّة الواسعة النطاق التي يشنّها فلاديمير بوتين على البلد الجار مستخدما، من أجل إخضاعه، أسلحة تقليدية وتهديدا بالسلاح النووي وحججا عفا عليها الزمن وأبعد ما تكون عن الواقع.
نسي بوتين أنّه في القرن الواحد والعشرين وأنّ ليس في استطاعته أن يكون ستالين آخر. لا يستطيع حتّى أن يكون ليونيد بريجنيف آخر، بريجنيف الذي قضى بالدبابات على “ربيع براغ” في العام 1968. تعامل في بداية ثمانينات القرن الماضي عن طريق انقلاب عسكري داخلي نفّذه الجنرال البولندي ياروزلسكي مع محاولات شعب بولندا للخروج من تحت نير الاحتلال السوفياتي. أرادت بولندا، وقتذاك، التخلّص من تحولها ضحيّة لمخلفات الحرب العالميّة الثانية التي قسمت أوروبا بين الغرب من جهة والنفوذ السوفياتي من جهة أخرى. أرادت الخروج من حصار “الستار الحديدي” الذي فرضه الاتحاد السوفياتي على دول أوروبا الشرقيّة وكان من نتائجه تقسيم ألمانيا.
استطاع فلاديمير بوتين إيقاظ أوروبا من جديد على كوابيس كانت تظنّ أنّها صارت من الماضي، بل دفنت في مكان عميق لا تستطيع الخروج منه. يتجاوز ما فعله الرئيس الروسي كلّ منطق ويتجاوز خصوصا كلّ ما له علاقة بالقيم الحضاريّة في هذا العالم الذي يبدو واضحا أنّه لم يدرك خطورة السلوك الروسي إلّا بعد بلوغه أوروبا.
قبل حرب أوكرانيا تجاهل العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، مآسي عدة من بينها مأساة لبنان ومأساة سوريا ومأساة العراق ومأساة اليمن على وجه التحديد. لم يوجد من يسأل ما الذي فعلته إيران بلبنان وكيف تسببت في انهيار مؤسسات الدولة والبلد نفسه بعدما استثمرت طوال أربعة عقود وأكثر في ميليشيا مذهبيّة أسمتها “حزب الله”. تدين هذه الميليشيا بالولاء المطلق لـ”الجمهورية الإسلاميّة” في إيران. الغريب أن روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي لم يفعلا شيئا في يوم من الأيّام من أجل مساعدة لبنان وكشف حقيقة ما يجري على أرضه. أمّا الغرب عموما، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد تعاطى مع المأساة اللبنانيّة من زاوية إنسانيّة لا أكثر رافضا الاعتراف بأنّ ما قامت به إيران في لبنان وفي سوريا والعراق واليمن لاحقا أسّس لانفلات على الصعيد الدولي.
ليس تصرّف فلاديمير بوتين تجاه أوكرانيا سوى تعبير صادق عن هذا الانفلات الذي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وميثاق حقوق الإنسان.
ثمة حاجة إلى درس التجربتين الإيرانيّة والروسيّة في سوريا بغية معرفة لماذا أقدم فلاديمير بوتين على مغامرته الأوكرانيّة
من الواضح أنّ حرب أوكرانيا جعلت كلّ دولة أوروبيّة تشعر بأنّها مهددة في الصميم. ماذا تستطيع دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) الضعيفة عسكريا والتي كانت جمهوريات سوفياتية عمله في حال نجح فلاديمير بوتين في أوكرانيا؟
هذا الخوف الأوروبي يفسّر الموقف الألماني الذي فاجأ الرئيس الروسي، خصوصا بعدما قررت ألمانيا إرسال مساعدات عسكريّة إلى الجيش الأوكراني وتخصيص مئة مليار يورو لإعادة بناء جيشها وتطويره. ليس الموقف الألماني الوحيد الذي يفترض التوقف عنده. خرجت سويسرا عن حيادها وقررت المشاركة في فرض عقوبات ذات طابع مصرفي على أتباع بوتين. من كان يتصوّر يوما أن سويسرا يمكن أن تتغيّر؟
تعيش أوروبا كلّ الهواجس التي هيمنت إبان الحرب العالميّة الثانية والسنوات التي سبقتها والتي شهدت صعود نجم رجل مريض اسمه أدولف هتلر. على أيّ أوروبي يستمع إلى فلاديمير بوتين يتحدث بالطريقة التي يتحدث بها عن أوكرانيا وعن أمجاد الاتحاد السوفياتي وضْع يده على قلبه. لكنّ على كل أوروبي التمعّن أيضا بالسلوك الروسي في سوريا للتأكد من أنّ القارة القديمة تتعاطى في هذه الأيّام مع رجل لا علاقة له بالواقع.
ثمة حاجة إلى درس التجربتين الإيرانيّة والروسيّة في سوريا بغية معرفة لماذا أقدم فلاديمير بوتين على مغامرته الأوكرانيّة. لم يجد بوتين من يردعه في سوريا. مهدت له إيران الطريق للعودة بقوة إلى سوريا والمشاركة في الحرب المستمرّة منذ أحد عشر عاما على الشعب السوري. استعانت إيران بالروس في العام 2015 بعد فشل ميليشياتها في الدفاع عن نظام أقلّوي على رأسه بشّار الأسد ترفضه أكثريّة السوريين.
عندما يكتشف فلاديمير بوتين أن ما قام به في سوريا، بالتفاهم مع إيران، مرّ مرور الكرام، يبدو ذهابه إلى أوكرانيا طبيعيا. ما يجده الرئيس الروسي طبيعيا أكثر إجباره بشّار الأسد على الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين في أوكرانيا وهما دونيتسك ولوغانسك. عشية الهجوم الروسي على أوكرانيا ذهب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى قاعدة حميميم الروسيّة قرب اللاذقية واستدعى بشّار إليها وأبلغه بقرار الهجوم. طلب منه الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين. بالفعل توجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو وأعلن منها الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. تنظر موسكو إلى النظام السوري بصفة كونه مجرّد تابع لها.
منذ اليوم الأوّل للتدخلين الإيراني والروسي في سوريا جلس العالم يتفرّج. لم ينبس باراك أوباما ببنت شفة عندما استخدم بشّار الأسد السلاح الكيمياوي في حربه على شعبه صيف العام 2013. من هذا المنطلق، اعتبر فلاديمير بوتين أنّ كلّ شيء مسموح له في أوكرانيا في عالم يطلق فيه الحوثيون من اليمن صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، من إنتاج إيران، في اتجاه الأراضي السعوديّة والإماراتية من دون حسيب أو رقيب.
نعم، أوروبا مختلفة. التهديد الروسي لها، انطلاقا من أوكرانيا، يأخذ بعدا مختلفا. لكنّ المنطق يقول إنّ العالم واحد وإنّ المشكلة مع بوتين بدأت عندما تساهل معه هذا العالم في سوريا مثلما تساهل مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن…
العرب
————————
ثروة آل مخلوف في روسيا عرضة للعقوبات الاميركية/ إياد الجعفري
لا أحد يعرف ما هو مصير الحساب المصرفي المزعوم، الذي افتتحه رئس النظام السوري بشار الأسد، قبل نحو 9 سنوات، في “في تي بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا. كما لا يُعرف مصير نحو 2.4 مليار دولار، حوّلها البنك المركزي السوري إلى البنك الروسي المشار إليه عام 2012، وفق معطيات غير موثّقة، تم تداولها في ذلك العام، على نحو واسع. كذلك لا يمكن الجزم بمصير حسابات بالروبل وعملات أخرى، قِيل إن المركزي السوري افتتحها في البنك الروسي ذاته، قبل نحو 10 سنوات.
المعلومات السابقة، نفاها بنك “في تي بي” الروسي، جُملةً وتفصيلاً، خلال السنوات المشار إليها، وذلك قبل أن يُوضع على قائمة العقوبات الأميركية عام 2014، على خلفية كونه ذراعاً مصرفياً للكرملين، تمتلك الحكومة الروسية 60 في المئة من أسهمه. البنك ذاته، والذي يمتلك 20 في المئة من الأصول المصرفية الروسية، بات في حالة “حظر كاملة”، بموجب أحدث العقوبات الأميركية على البنوك الروسية.
وعلى غرار المعطيات التي سردناها في المقدمة، فإن كل التكهنات بخصوص حجم ومواطن تخبئة الثروات الشخصية لآل الأسد وأقاربهم، في “الملاذ” الروسي سابقاً، وبالتالي حجم الأضرار التي ستنال منها بفعل العقوبات الغربية على روسيا، تبقى في إطار التخمين والتحليل، دون دليل، ذلك أن شبكة معقّدة من غسيل الأموال ونقلها، تميزت بالعمل عبر القنوات الروسية، كانت أسماء بارزة، تحمل الجنسيتين السورية والروسية، تشكل رأس جبل الجليد، أبرز تلك الأسماء، مدلل خوري وعائلته، وهو مصرفي سوري-روسي، ترأس شبكة، ساعدت محمد مخلوف، خال الأسد، في نقل جزء من ثروات العائلة إلى روسيا، ومنها، إلى “جنات ضريبية” في الجزر العذراء ودول أوروبية، وذلك بدءاً من العام 2012. وتذهب تقديرات إلى أن تلك الشبكة التي أدارها خوري، تعاملت مع ثروات بحجم 4 مليارات دولار، وفق تقرير ل”التايمز” البريطانية، نُشر عام 2020.
الموثّق من المليارات الأربعة تلك، 40 مليون دولار تحولت إلى عقارات في ناطحات سحاب فاخرة بالعاصمة موسكو، تعود لآل مخلوف، وفق ما كشفه تحقيق لمنظمة “غلوبال ويتنس” الناشطة في ملاحقة المال الفاسد، نُشر عام 2019. لكن ما تحول إلى أموال غير منقولة –عقارات- هو جزء يسير للغاية مما تم نقله، إلى ملاذات أخرى، حسبما كشف تسريب بيانات بنك “كريدي سويس” السويسري، قبل فترة وجيزة، والذي يؤكد وجود حساب بنكي باسم محمد مخلوف، خال الأسد، الذي تُوفي عام 2020، لم يُكشف عن قيمة الأموال المتوفرة فيه. يؤشر ذلك إلى أن الجهاز المصرفي الروسي كان إحدى المحطات لتهريب أموال آل مخلوف، إلى خارج سوريا، خلال السنوات التي تلت العام 2012. وقد استخدم مخلوف الأب، عبر شبكة مدلل خوري، بنكَين، في هذا السياق، الأول، بنك صغير في موسكو، اسمه تيمبانك. وهو ذاته البنك الروسي الذي تعاون معه البنك التجاري السوري عام 2012، بهدف فتح حساب مقايضة لمبادلة السلع أو النفط، بمواد غذائية، تهرباً من العقوبات المفروضة بعد العام 2011. البنك الروسي المشار إليه، خضع للعقوبات الأميركية بعد العام 2014، على خلفية ضم روسيا لجزيرة القرم. وأُغلق بشكل كامل عام 2017.
أما البنك الثاني، الذي تعامل معه مخلوف الأب، فكان “سبيربنك”، أكبر بنوك روسيا، والذي تملك الحكومة أكثر من نصف أسهمه. فقد ساهم البنك في صفقة واحدة على الأقل من الصفقات التي نفذتها شركات تتبع لحافظ مخلوف (أحد أبناء مخلوف الأب) لشراء الشقق الفاخرة في ناطحات السحاب الروسية. وقد أصبح “سبيربنك”، أحد ضحايا العقوبات الأميركية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
لا يُعرف كم بقي من تلك الأموال التي هرّبها مخلوف الأب إلى روسيا، داخل هذا البلد. لكن أسلوب حياة ساندرا، ابنة مدلل خوري، الذي يمكن الاستدلال على مدى رفاهيته عبر حسابها على إنستغرام، يؤشر إلى مدى الثراء الذي تعيشه عائلة اشترك معظم أفرادها في تمرير أموال أقارب الأسد عبر روسيا. الأب مدلل خوري، والعم الأول عطية خوري، والعم الثاني عماد خوري، والابنة ساندرا. أما الأخيرة، فأسست منذ مدة، مبادرة دفع غير نقدية تحت اسم “سيندي”، في مسعى لدخول عالم الأعمال، مستفيدةً من احتجابها حتى الآن عن العقوبات الغربية، التي تطاول والدها وعمّاها.
لكن، ماذا عن الثروات الشخصية لبشار الأسد، أو شقيقه، في روسيا؟ لا توجد أية معلومات موثوقة بهذا الصدد. وحتى التكهنات تبدو متهالكة. إذ من المُفاجئ أن يترك الأسد، ثروات شخصية له، قريبة من قبضة الكرملين الذي ضغط عليه مراراً لتسديد ديون نظامه المتراكمة لصالح موسكو. كذلك، من غير المنطقي، أن يترك ماهر الأسد ثروات له في روسيا، وهو الذي تنظر إليه موسكو بوصفه ذراعاً إيرانياً في سوريا. وبالتالي، فإن أبرز المتضررين من انكشاف الجهاز المصرفي الروسي أمام العقوبات، هم آل مخلوف، الذين يتلقون ضربة جديدة، تُضاف إلى الضربات التي تلقوها على مدار السنتين الفائتتين. إذ من المرجح أن يكون لهم حسابات بنكية في روسيا، التي يعيش معظمهم فيها، الآن. فاختفاء رامي مخلوف تماماً، مع إزاحته بصورة كاملة عن “سيريتل”، وتحويل كامل قطاع الاتصالات في سوريا إلى قبضة الأسد وزوجته أسماء، يؤشر إلى أن التسوية بين مخلوف-الأسد على تقاسم الثروة التي كان يديرها الأول، انتهت إلى ترك جانب كبير من الأموال المنقولة في الخارج لآل مخلوف، مقابل استيلاء الأسد على مواطن الثروة غير المنقولة في الداخل. تلك الأموال المنقولة التي ظهر أولاد رامي، مراراً، وهم ينعمون بخيراتها، في فيديوهات أثارت غيظ الموالين، تعرضت لانكشاف في تسريبات “كريدي سويس”. وقد تكون في طريقها لأضرار كبيرة مع تفاقم العقوبات والأضرار على البنوك الروسية.
المدن
——————————-
بعد الدرس الأوكراني: هل تقرّ الدول بأخطائها في سوريا وتسمح بإصلاح المعارضة؟/ عقيل حسين
حظيت المقارنات بين قيادة الحكومة الأوكرانية لأزمة بلادها مع العدوان الروسي وبين قيادة المعارضة السورية للمعركة مع النظام في حربه على الشعب، بتفاعل كبير خلال الأيام الماضية، ورغم الانقسام في وجهات النظر إلا أن غالبية السوريين متفقون على ضرورة أن تحظى الثورة بممثلين على مستوى أفضل لقيادتها.
المقارنة بدأت مع الحضور المميز للرئيس الأوكراني ووزير دفاعه وبقية المسؤولين الرئيسيين في الحكومة، حيث اعتبر الكثيرون أن نجاح الأوكرانيين في إدارة الأزمة سببه الرئيسي كفاءة القائمين عليها، الأمر الذي افتقدته الثورة السورية حتى الآن.
وذهب البعض أبعد من ذلك عندما رأوا أن المسؤولين الأوكرانيين، ومن خلال وجودهم المستمر بين الناس ووسط المعارك، وكذلك بتمسكهم بالمواقف والثوابت التي أعلنوا عنها، قلبوا كل الحسابات التي كانت تصب في صالح القوة الروسية، وأفشلوا مخططات بوتين التي كانت تتطلع لحسم المعركة خلال أيام قليلة.
مقارنة ظالمة
لكن وجهة النظر هذه على كل ما فيها من صحة، إلا أنها لا تأخذ بالاعتبار، حسب الكثيرين أيضاً، معطيات عديدة أسهمت في النجاح الذي حققه الأوكرانيون حتى الآن.
وفي هذا الصدد أشار المعارض السوري عبد المنعم زين الدين أن المقارنة المنتشرة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وبين الثورة السورية بهذه الطريقة من جهة أخرى ليست عادلة، لأنها تتجاهل العديد من الاعتبارات.
وقال في منشور له على حسابه في موقع تليغرام: في سوريا الجيش تركيبته طائفية، وقد وقف ضد الشعب السوري وثورته، إلا القلة الحرة التي انشقت عنه، وهو شريك المحتلين القتلة، بينما في أوكرانيا فإن الجيش وطنيّ يحمي الشعب ويقاتل المحتلين الغزاة.
وأضاف: في سوريا بدأ الثوار معركتهم سِلمياً لا يمتلكون أيّ سلاح، وظلوا شهوراً يواجهون الرصاص بصدورهم، وسلاحُهم حناجُرهم فقط، أما أوكرانيا، فقد بدأت معركتها منذ اللحظة الأولى، وهي بكامل سلاحها المجهز بالطائرات والعربات والمدرعات ومنظومات الصواريخ والاتصالات والمضادات وغيرها.
كما إنه بما يخص سوريا، فإن المواقف الدولية المنددة بجرائم النظام لم تتحرك إلا بعد مدة طويلة، ولم تتضمن خلال عشر سنوات إلا مجرد تصريحات ومواقف دبلوماسية شكلية، بالمقابل فإن المواقف الدولية سبقت المعركة، بأوكرانيا، ومع أول ساعات الحرب، وخلال أيام تجسدت بخطوات قوية في دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا.
كما نوه زين الدين إلى الفرق الشاسع في الدعم الذي حظي به كل طرف، فـ “في الثورة السورية منع الدعم العسكري النوعي عن الثوار، أما أوكرانيا، ورغم امتلاكها ترسانة سلاح ضخمة تشمل آلاف الدبابات والعربات ومئات الطائرات، وجيشاً ضخماً مجهزاً، إلا أن الدول الغربية وخلال الأيام الأولى من المعركة تسابقت على دعمها بأعداد هائلة من الطائرات وصواريخ مضادات الطيران والدروع وكل أنواع الدعم العسكري”.
كما ركز على استخدم العدو كل أنواع الأسلحة المحرمة في جميع أنحاء سوريا ضد الثوار والمدنيين ( عنقودي – فراغي- ارتجاجي- فوسفوري – كيميائي) إضافة للبراميل المتفجرة، بالمقابل فإنه “حتى الآن هناك تخوف روسي من عواقب استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا، حتى وإن هدد ببعضها واستعرض”.
وخلص زين الدين إلى أنه “لا مقارنة مطلقاً بين الثوار في سوريا وبين أوكرانيا، لا من حيث الظروف ولا مقومات الصمود، ولا المساحة والإمكانات، ولا المواقف الدولية، ولا حجم وحشية العدو وتدميره للمدن، ولا أي شيء آخر”، مذكراً بالأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا من قادة الثورة العسكريين ومن الناشطين والمقاتلين والمدنيين الذي سطروا ملاحم بطولية من التضحيات من أجل قضيتهم العادلة التي لم تحظ بالدعم والمساندة المطلوبة.
لا مقارنة
لكن البعض يرى أن مجرد المقارنة بين الحالة الأوكرانية والثورة السورية غير منطقية ولا تصح، بحكم الاختلافات الموضوعية والذاتية بين الحالتين، مع الإقرار بالدور المهم الذي لعبته “القيادة” سواء سلباً أو إيجاباً.
وحسب هؤلاء فإن الفرق كبير بين ثورة شعبية ضد السلطة الحاكمة التي تتسبب عادة بانقسام مجتمعي، مقابل عدوان خارجي يستجيب له المجتمع بأعلى درجات التوحد، إضافة إلى أن قيادة الثورة والمعارضة السورية لم يتم فرزها بشكل منظم، بينما دخل الأوكرانيون المعركة وهم ضمن دولة مستقرة تتمتع بمؤسسات قوية، بما في ذلك مؤسسة الجيش الوطني، وتقودها حكومة منتخبة تمثل الشعب.
بل إن وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، يرى أنه وإلى جانب الاختلاف في طبيعة ومضمون الملفين، فإن مصالح الدول المتباينة بين أوكرانيا وسوريا كان له الدور الحاسم في إيصال الأمور إلى ما وصلت إليه في كلا البلدين.
ويقول في تصريح لـ”أورينت نت:” معظم الدول الفاعلة كان لها مصلحة في إطالة عمر الحرب في سوريا من أجل استنزافها وانهاكها، وهي مصلحة إسرائيلية روسية إيرانية قطعاً، إضافة إلى أن بعض الدول الغربية كانت تسعى لتوريط إيران وروسيا في المستنقع السوري من أجل استنزافها فيه أيضاً، بينما في أوكرانيا فالجميع كانت لديه مصلحة في عدم انتصار الروس وإلحاق الهزيمة بهم.
ولذلك، يعتقد علوان، أن التدخلات المستمرة في عمل المعارضة السورية وتشكيلاتها والتلاعب ببنيتها وخيارات تمثيلها كان متعمداً من غالبية الدول التي أعلنت وقوفها إلى جانب الثورة، واستفادت من هذه الفوضى لأجل التدخل المباشر أو غير المباشر عبر، فاعلين محلين لتحقيق مصالحها، مقابل تماسك القيادة الأوكرانية ووضوح هويتها المستمدة أصلاً من صدورها عن إرادة الشعب وعبر انتخابات ديمقراطية، الأمر الذي سيحد بالطبع من التدخل الخارجي في رسم سياسات الحكومة، وهو ما لم يكن متوفراً في حالة الثورة السورية.
فرصة
لذلك فإن العديد من المحللين يرون أن الحدث الأوكراني يجب أن يمثل فرصة استثنائية لكي تراجع القوى الرئيسية سياساتها وأساليب تعاملها مع الملف السوري، وخاصة لجهة التدخلات في مؤسسات المعارضة التي كانت سلبية غالباً وأدت إلى وصولها إلى المستوى الحالي من الضعف والترهل.
وهنا يعتقد الديبلوماسي السوري المنشق بسام بربندي أنه إذا كان هناك نية للاستفادة من الدرس الأوكراني بما يخص سوريا، فيجب أن يبدأ من المساعدة بانجاز إصلاح مؤسسات المعارضة وتمكينها.
ويقول في حديث مع “أورينت نت”: على المجتمع الدولي التوقف عن دعم استمرارية المسؤولين الحاليين في مؤسسات المعارضة، والسماح للسوريين بإنتاج قيادات أكثر تمثيلاً للشارع وتعبيراً عنه، بما يؤدي إلى التماهي المطلوب بين الشعب وقيادته من المعارضة، مع التأكيد على أن هذا الإصلاح يبدأ من قبلنا نحن السوريين.
ويضيف: المجتمع الدولي يعترف بالائتلاف كواجهة وحيدة للمعارضة السورية، وهذا الاعتراف جاء بنص قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول الفاعلة بالملف السوري تخشى من أن يؤدي خروج هذه المؤسسة من المشهد إلى انتهاء مفعول هذه القرارات، لذلك فالجميع متمسك بها ويقولون لنا إن عليكم المحافظة على هذا الجسم السياسي، لكن أعضاء الائتلاف فهموا أن هذا يعني المحافظة عليهم هم كأشخاص في الائتلاف وليس الائتلاف كمؤسسة !
وحول إمكانية أن تجد أفكار إصلاح الائتلاف وبقية مؤسسات المعارضة طريقها للتطبيق بتأثير الدرس الأوكراني بعد أن استعصت من قبل، ومدى توفر شروط ذلك حالياً، يقول بربندي: كانت هناك محاولات عديدة في السابق أجهضت، ودائماً لعبت التدخلات الخارجية ورغبة الدول بالحفاظ على وكلائها الدور الأساسي في ذلك، ولذلك خرج طرح أخير بإجراء انتخابات للائتلاف بعيداً دائرة التأثير الخارجي، لكن بعض الدول الاقليمية رفضت ذلك لأنها لا تريد أن تخسر محاصصتها، بينما لم يعد الملف يعني للأمريكان والأوربيين الكثير خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أبقى الوضع على ما هو عليه، لكن اليوم أعتقد أن الجميع يجب أن يقر أن مصلحته هو في وجود معارضة قوية وفاعلة ومعبرة عن الشارع.
ويتفق وائل علوان مع بربندي في أن المعارضة السورية أمام فرصة استثنائية اليوم ليس فقط لتصحيح وضعها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي، بل وكذلك من أجل أن تستأنف مؤسساتها دورها الطبيعي كممثل للشعب السوري وكبديل للنظام أيضاً.
ويقول: لنفترض الآن أن المجتمع الدولي قرر معاقبة بوتين في سوريا أيضاً من خلال التخلص من النظام التابع له، فهل المعارضة بواقعها الحالي قادرة على أن تكون بديلاً ناجعاً؟ بالتأكيد لا، وعليه، ولأن هذا الاحتمال بات وارداً وبقوة حتى وإن لم يكن خلال وقت قصير، فإن على المعارضة أن تكون بحجم المسؤولية التاريخية اليوم وتتحرك بجدية وبإخلاص لإصلاح مؤسساتها.
لا مقارنة إذاً بين ظروف المعركة الأوكرانية بمواجهة العدوان الروسي، وظروف معركة الشعب السوري ضد النظام وحلفائه، لكن الدرس الأهم الذي يجب الاستفادة منه هو ضرورة وجود قيادة متماسكة وممثلة للشعب تدير المعركة وتزيد من فرص الانتصار بها.
أورينت نت
—————————
الغزو الروسي: أنظمة المنطقة محتارة/ عروة خليفة
بدا الموقف الرسمي للأنظمة في المنطقة العربية، وتحديداً دول الخليج، من الغزو الروسي لأوكرانيا متردداً حتى مع تصاعد الإدانات الدولية والغربية للحرب الروسية على جارتها الأصغر، ومع تتابع إعلان الإجراءات العقابية على الصعد الاقتصادية والسياسية لبوتين وموسكو على خلفية تلك الأحداث.
وفي حين يمكن وضع مواقف دول تمتلك تحالفات عسكرية ودبلوماسية قديمة مع موسكو، مثل الجزائر، في سياق تاريخي؛ فإنّ موقف الدول الخليجية الذي اقترب من الصمت والحياد أغلب الوقت، مبتعدين بذلك عن مواقف حلفائها في واشنطن، كان مبعثاً للتساؤل، وحتى الإحباط، عند دبلوماسيين غربيين لاحظوا هذا التردد وأشاروا إليه، خاصةً الموقف الإماراتي بالامتناع عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت في الخامس والعشرين من شباط (فبراير)، والتي انتهت بفشل مشروع القرار بسبب الفيتو الروسي.
وقد برر أحد الدبلوماسيين الغربيين في تصريح لوكالة فرانس برس الموقف الإماراتي بعد الجلسة بنوع من المبادلة «غير النظيفة» مع روسيا لقرار ضد الحوثيين. لم تخفِ الدول الغربية شعورها بالإهانة من الموقف المتردد الذي اتخذته الإمارات وقتها، وهي ردّة فعل قد تكون أحد دوافع الإمارات إلى تغيير موقفها لاحقاً في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصويتها مع مشروع قرار إدانة روسيا.
كان الموقف الأقرب للوضوح بين مواقف الدول الخليجية هو الصادر عن الخارجية القطرية، والتي مع ذلك لم تُدِن روسيا أو الغزو، واكتفت بإدانة أعمال العنف والتأكيد على اعتراف الدوحة بسيادة أوكرانيا على أراضيها.
لكن، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها الطارئة على مشروع القرار الخاص بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن الحديث عن تغيير في الموقف. فبعد امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن على قرار إدانة موسكو، عادت وصوتت لصالح القرار الدولي في الجمعية العامة، وبالمثل قامت كل دول الخليج العربي بدعم القرار والتصويت لصالحه خلال جلسة الجمعية العامة. كما شاركت قطر والكويت في طرح مشروع القرار، ما يبدو عودة منهم إلى مقاعد التحالف مع الولايات المتحدة، التي رفعت من حدة التصعيد السياسي مع موسكو إلى مستويات عالية للغاية، لم نشهد لها مثيلاً منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي.
بدورها، أصدرت مصر بياناً شديد الحياد حيال ما يحصل في أوكرانيا عند بداية الغزو الروسي، ثم عادت وأيدت القرار الأممي مع تحفظ البيان الصادر عن مندوبها في الأمم المتحدة على بعض الإجراءات المتخذة ضد روسيا، مثل العقوبات الاقتصادية التي اعتبرها البيان تؤدي فقط إلى الإضرار بالمدنيين والمواطنين العاديين. لبنان وليبيا أيضاً صوّتا لصالح القرار. وكانت ثلاث دول عربية قد امتنعت عن التصويت على القرار في الجمعية العامة، وهي الجزائر والسودان والعراق، فيما تغيّب المغرب عن الجلسة ولم يصوت.
خلال الأسبوع الماضي اعتمدت التحليلات على عامل أو إثنين في تفسير الموقف الخليجي المتردد مما يجري من حرب في أوروبا وعدم مجاراتهم للموقف الغربي الذي صعّد في إدانة موسكو وفرض العقوبات عليها نتيجة العمليات العسكرية.
اعتمدت بعض التحليلات على مسألة المقايضة بين الإمارات وروسيا حول قرارات في مجلس الأمن، من خلال عدم عرقلة موسكو قراراً يدين الحوثيين في اليمن مقابل امتناع أبو ظبي عن التصويت فيما يخص قرار الإدانة المدعوم غربياً. لكنّ هذا السبب قد لا يفسر الموقف القطري أو الكويتي على سبيل المثال، وبالطبع لا يفسر الموقف المصري المتردد من اتخاذ موقف واضح حول ما يجري في أوكرانيا.
كما أُخذت بعين الاعتبار مسألة أهمية التحالفات في أوبك+، وهو تحالف يشمل الدول الأعضاء في منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) مضافاً إليها عدد من الدول الأخرى على رأسها روسيا، وأهمية هذا التحالف بالنسبة للسعودية من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط.
في الحقيقة، هنالك عدّة مستويات من التأثير، لعبت أدواراً مختلفة الأهمية بالنسبة لدول المنطقة بما يتعلق باتخاذ موقف واضح من عدمه بخصوص الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تقترب من التحليلات السابقة وقد تبتعد عنها. ففي الموقف القطري، الحذر إلى حدٍّ ما، على الأقل في البداية، أرادت الدوحة الحفاظ على خط مع موسكو، أكبر الشركاء في نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، وما يعنيه ذلك بالنسبة للدوحة، التي يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من أهمية كبيرة.
في المقابل فإنّ طموح الدوحة في زيادة نفوذها ضمن السوق العالمية للغاز يصطدم بالدور الروسي، ما يضعها في موقفٍ متعارض مع موسكو على المدى البعيد ضمن هذا الإطار.
أما بالنسبة للإمارات والسعودية فإنّ الرغبة باستقرار أسعار النفط ليس السبب الوحيد لتردّدهما في اتخاذ موقف معادي لموسكو. هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بأنّ الرياض تريد بقاء أسعار النفط المرتفعة على وضعها الحالي. وكانت السعودية قد رفضت رفع حجم إنتاجها من النفط رغم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ ما قبل الغزو الروسي، عندما تأثرت أسواق الطاقة العالمية بزيادة الطلب بسبب ارتفاع مستويات التصنيع والنمو العالمية، وبسبب التوتر الذي سبق الغزو الروسي. لذا تجد السعودية نفسها في مثل هذه الظروف بحاجة ماسة إلى المداخيل الإضافية التي يوفرها ارتفاع الأسعار حالياً، خاصةً بعد انخفاض الأسعار خلال جائحة كوفيد-19 في الأعوام الماضية إلى مستويات قياسية، وانخفاض معدلات النمو العامة في السعودية والإمارات نتيجة آثار الجائحة والتوترات في الخليج مع إيران، بالإضافة إلى تكاليف حرب اليمن التي أنهكت الاقتصاد السعودي على مدى سنوات. ستكون السعودية بحاجة إلى مثل تلك الزيادات وغير راغبة بالتخلي عنها في سبيل مواقف أكثر تشدداً لصالح الولايات المتحدة ضد موسكو المستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وسيكون لتخفيض أسعار النفط آثار اقتصادية كبيرة عليها خاصةً في ظل العقوبات وظروف الحرب الحالية.
كما قد يكون هذا الموقف رسالة خليجية، وسعودية بالأساس، إلى واشنطن نتيجة عدم اتخاذ الأخيرة مواقف متشددة من التعديات الإيرانية والحوثية، ومن الضربات التي تستهدف عمق الأراضي السعودية والإماراتية.
في المقابل، تمتلك الجيوش في الجمهوريات العربية شمال إفريقيا، تحديداً في مصر والجزائر وليبيا، علاقات تاريخية مع موسكو. ونتيجة سيطرة الجيش على الحكم، بشكل تام في مصر وكبير في الجزائر، فإنّ هذا التحالف التاريخي بين الطرفين وتوجس الجيش المصري من تراجع مبيعات السلاح الغربية إليه وحاجته إلى مصدر بديل للسلاح دفع لتلكؤ القاهرة في اتخاذ مواقف متشددة من موسكو. وعدا عن تصويته في الجمعية العامة لصالح القرار الذي يدين الغزو الروسي، لا يبدو أن النظام المصري سيقوم بردّات فعل كبيرة تثير استياء موسكو.
من جانبها، امتنعت الجزائر عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرار الذي يدين روسيا. تحتفظ الجزائر بعلاقات عسكرية هي الأقوى في المنطقة مع روسيا، حيث يعتمد الجيش الجزائري على السلاح الروسي بشكل كبير، كما أنّ علاقاته الأوروبية باتت أكثر تردياً بعد اتخاذ عدد من الدول الأوروبية المتوسطية مواقفاً داعمة للمغرب في الخلافات بين الطرفين، ما يعني مزيداً من ابتعاد الجزائر عن المواقف الغربية التي تتوجس منها قيادات الجيش الجزائري تقليدياً. هذا يضاف إلى أنّ قدرات الجزائر على رفع مستويات إنتاجها من الغاز الذي تصدره إلى أوروبا محدودة للغاية، حسبما صرح مسؤولون جزائريون، ما يعني عدم وجود أي منافع اقتصادية من اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في ظل عدم قدرتهم على الحلول محلها كمصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا.
هناك عامل رئيسي قد يكون غير محسوس بالنسبة للمحللين الذين يبنون نماذجهم على الوقائع الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وأنماط العلاقات التاريخية. في الحقيقة، تميل أنظمة هذه المنطقة إلى أن تكون شديدة الرجعية وشديدة التردد باتخاذ مواقف دبلوماسية واضحة حيال ما يجري في العالم، ويسيطر عليها دائماً الخوف من دفع أثمان، مهما صغرت، من مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة.
ويجب أن لا ننسى هوس هذه الأنظمة بمظاهر القوة والعظمة المصطنعة وإعجابها بها، إذ ليس من المصادفة أن يثابر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على افتعال مشاهد دخول إلى المؤتمرات والاجتماعات الرسمية مطابقة لما اعتاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديهما، عندما تصوره الكاميرا يمشي وحيداً في ممرات طويلة مظهرةً إياه امبراطوراً وحيداً. هوسٌ نجد له شبيهاً في منطقتنا، وإعجابٌ لا يخجل بذلك النوع من الشخصيات التي تعبد مظاهر الفحولة والسيطرة، وهو ما شاهدنا أمثلةً عليه في علاقة قادة بعض دول الخليج ومصر مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
تريد أنظمة المنطقة مناكفة الولايات المتحدة، ومعاتبتها على تقصيرها فيما يرونه واجباتها تجاههم. قد تصطدم بواقع عدم قدرتها على التمادي كثيراً في هذه المناكفة، لكنّها تحتفظ بذلك الإعجاب السري أو العلني بصورة الدكتاتور الذي يغزو بلداً آخر متحدياً القوى العظمى. إنهم، بطريقة أو بأخرى، يشجعون صدامهم الجديد مستمعين ربما إلى أغاني تمجد ذاك الذي مضى.
موقع الجمهورية
—————————
عن الاحتمالات المتزايدة للحرب النووية/ مهند الحاج علي
تتحول العقوبات الغربية القاسية على الجانب الروسي، الى حصار قد تكون تبعاته المالية والاقتصادية أشد وقعاً على روسيا من الحرب، وبالتأكيد ستتعاطى موسكو مع هذا التهديد المستدام على هذا الأساس. وفي موازاة ذلك، من الصعب أيضاً الجزم بأن المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، والسماح لمتطوعين بالمشاركة في المعركة ضد روسيا، ستمر دون رد ولو مؤجل من موسكو، سيما في ظل توالي التهديدات على لسان الرئيس فلاديمير بوتين وفريقه السياسي.
العقوبات والتصعيد العسكري ومأزق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، قد يُؤديان الى أزمة وجودية، ويدفعانه الى حافة الهاوية في اتخاذ القرارات، وهذا خطر. لهذا السبب، نرى أن عدداً من الخبراء المرموقين في المجال النووي باتوا يُبدون قلقهم من مسار الأمور، ويتوقعون للمرة الأولى منذ عقود احتمالات تطور الوضع باتجاه اللجوء لهذا الخيار في حال تواصل تصعيد كل الأطراف.
جايمس أكتون مدير البرنامج النووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، كتب مقالاً عن التهديد النووي في صحيفة “واشنطن بوست”، داعياً الإدارة الأميركية وحلفاءها الى فتح كوة في الجدار وتأمين مخرج للرئيس الروسي بهدف تجنب مواجهة “نووية”. “الخطر بالحقيقة جدي تحديداً لأن التهديدات النووية لروسيا لن تنجح” في تحقيق أي أهداف سياسية، وفقاً لأكتون، وسنكون أمام بوتين معزول وغاضب يخوض حرباً تقليدية طويلة، ويُدير اقتصاداً يتحطم على وقع العقوبات الغربية. في هذا الموقف، تزداد احتمالات اللجوء الى الخيار النووي.
هذا التقويم لاحتمالات الخطر النووي يتقاطع مع كلام خبير آخر هو البروفيسور الإسرائيلي ديما أدامسكي الذي نشر أخيراً كتاباً بعنوان “العقيدة النووية الروسية: الدين والسياسة والاستراتيجية”. أدامسكي، كما نقل عنه عاموس هرئيل في صحيفة “هآرتس”، يرى ان بيان بوتين “النووي” احتوى على مفردات دينية وتاريخية لو أضفناها الى المسار المتوتر للحرب، فإنها تُثير القلق من هذا الاحتمال القاتل.
صحيح أن الهدف الروسي من هذه التهديدات النووية، هو تحقيق أهداف على الأرض من خلال دفع الطرف الآخر للتنازل عسكرياً أو سياسياً (تعهد بعدم الانضمام لحلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وتسوية بشأن المناطق المتنازع عليها). إلا أن عدم تحقيق هذا الهدف، وتباطؤ التقدم الروسي، أيضاً يُؤديان الى ارتفاع احتمالات اللجوء لهذا الخيار، بما أن التهديد أو التلويح به لم ينفع في السير قدماً. وهذه ورطة لجميع الأطراف. في ظل التهديد النووي، هناك حدود لمدى الهزيمة التي بالإمكان إلحاقها بالخصم. إذا كانت إيران ردت على العقوبات بقصف الدول المجاورة، لماذا على روسيا أن تقبل بأقل من ذلك؟
هرئيل ينقل تحليلاً عن خبيرة أخرى من جامعة هارفرد هي الدكتورة فيونا هيل، مفاده أن بوتين واضح في كلامه عن وضع الخيار النووي على الطاولة، وهذا الرجل “إن كانت لديه وسيلة يستخدمها، وإلا فلماذا يملكها؟”. وأشارت الى استخدام روسيا بقيادة بوتين، مادة البولونيوم المشعة لتسميم خصوم سياسيين، و”إذا كان هناك من يعتقد بأن بوتين لن يستخدم سلاحاً يملكه لأنه وحشي، فليُعد حساباته”.
بغض النظر عن هذه الحسابات، بالإمكان اليوم توفير مخرج لائق بالحد الأدنى لروسيا دون تنازلات كبرى. انسحاب روسي من أوكرانيا مقابل تعهد من قيادتها بعدم الانضمام للحلف الأطلسي، ورفع تدريجي للعقوبات الغربية. وعلى الجانب الروسي التراجع عن قرار ضم شبه جزيرة القرم، والاعتراف بالسيادة الأوكرانية على المناطق المتنازع عليها، أو بعضها. المهم أن التنازل طريق مؤلم للحل، وكما يقول أكتون في مقاله، فإن “إنهاء الحروب يشمل دائماً تنازلات مؤلمة، وهي في نهاية المطاف أفضل من البدائل الأخرى ومن ضمنها في هذه الحالة، حرب نووية”.
المدن
—————————
غزو أوكرانيا: هل نصدق أن أوروبا لم تعد نفسها؟/ حازم الأمين
ما شهدناه خلال الأسبوع الفائت في القارة العجوز مخيف لجهة سرعة استجابة مجتمعات ودول “عاقلة” لنداء الثأر.
بعد أقل من أسبوع على مباشرة فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، أطاحت ذاكرة أوروبا بعقلها، فالأخير على ما يبدو راح ينمو على نحو مغاير عن الذاكرة، لا بل إن الابتعاد عن الذاكرة كان أحد شروط نمائه. من السهل دحض هذه الفكرة، لكنها تملك حظوظاً لا بأس بها من الصحة. فما شهدناه خلال الأسبوع الفائت في القارة العجوز مخيف لجهة سرعة استجابة مجتمعات ودول “عاقلة” لنداء الثأر.
أولاً يجب أن يبدأ هذا العرض ليس فقط من إدانة الغزو، انما بالخوف والذهول من حقيقة أن دولة تملك أكثر من خمسة آلاف رأس نووي يحكمها فلاديمير بوتين. وأن رجلاً مهووساً مثل زعيم الكرملين قرر الخروج من عزلته حاملاً حقيبة نووية، وهو الآن ليس بصدد احتلال بلد، انما بصدد محوه.
لكن المذهل أيضاً أن الحرب العالمية الثانية كتجربة وكخبرة ما زالت مزروعة في الوعي الأوروبي على رغم مرور نحو سبعين عاماً على نهايتها، وهذا الزرع سريعاً ما أتى أُكله، فبين يوم وليلة قررت ألمانيا التي منعت من التسلح طوال السبعة عقود الفائتة أن تتسلح. وفي هذه اللحظة باشرت بولندا خوفاً ضمنياً من تسلح ألمانيا، ناهيك عن خوفها من بوتين، ذاك أن ألمانيا معززة بترسانة أسلحة أيقظت ببولنديين خوفاً قديماً عمره سبعة عقود!
أي معضلة هذه، فألمانيا هذه المرة إلى جانب بولندا في مواجهة بوتين، ولكن الخوف القديم لا يقيم وزناً للعقل. جزء من أوروبا، لم يشف بعد من الخوف من ألمانيا المسلحة.
ليس هذا فحسب، فقد كشف الغزو عن قابليات تحتاج إلى نقاش وتأمل، أن تتخذ أوروبا قراراً سريعاً بحجب وسائل إعلام روسية وبمنع بثها في دول الاتحاد، فهذا أمر يحتاج للتوقف عنده، لا سيما وأنه لم يُمهد له بنقاش حول دلالاته لجهة عدم انسجامه مع حريات طورتها دول الاتحاد على مدى عقود. نحن هنا حيال قرار بالمنع، فهل اتخذ في سياق ما يشبه “قانون طوارئ”، أم أن المادة الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام هذه لا تنسجم مع القيم الأوروبية. مع العلم أن أوروبا قبلت ببث هذه المحطات وبمحتواها البصري والمكتوب بما يتعلق بدور روسيا في سوريا، وقبلها باحتلالها منطقة القرم!
والمرء إذ يذهب أكثر بمخاوفه، تلوح له الأخبار عن تجميد أرصدة المتمولين الروس وقرارات مصادرة أملاكهم في أميركا ودول الاتحاد بوصفها نوعاً من العقاب الجماعي، ذاك أن الأخبار لم تتضمن تمييزاً بين رجال الأعمال وأصحاب الأملاك المقربين من النظام في موسكو وبين غيرهم من الروس، والوقت لا يساعدنا كثيراً للبحث عما اذا تضمنت القرارات تمييزاً، ذاك أن الحرب أسرع من محرك البحث، والقرارات المتلاحقة لا تمهلنا كثيراً، فعلينا التدقيق بما يليها من أخبار، خصوصاً اذا كانت من وزن تعليق تدريس دوستويفسكي في أحد الجامعات الإيطالية ولو موقتاً، ناهيك عن ذلك الهراء الذي تضمنته رسائل المراسلين الصحافيين عن اللاجئين أصحاب الشعر الأشقر والعيون الزرقاء، أو عن إقحام الرياضة والرياضيين في دوامة مواجهة لا يد لها ولهم فيها، وهي توجت بصرخات نجوم روس ضد الحرب شملتهم الإجراءات العقابية.
إنها الذاكرة، وهي هذه المرة ليست درساً لتجاوز الماضي والذهاب إلى ما بعده، انما بوصفها قدراً من المحتمل أن يعاود اشتغاله. وهنا لا بد للمرء، ومن على هذه المسافة التي تفصله عن أوروبا أن يخاف من بوتين طبعاً، لكن أن يخاف على أوروبا من ذاكرتها، وأن يخاف على قيم لطالما تمنى أن تتسرب إلى بلاده.
رجل مهووس وراء هذا التحول. فهل صحيح أن الكوكب هش إلى هذا الحد.؟
درج
————————-
الأوكرانية والروسية ولغة الحرب/ إيليا كامينسكي
ترجمة: يزن الحاج
1
عائلتي محتشدةٌ عند إطار الباب الساعة الرابعة فجرًا، يتجادلون ما إذا كانوا سيفتحون الباب للغريب الذي لا يرتدي إلا بنطلون البيجاما، ويقرع الباب منذ خمس دقائق على الأقل، موقظًا المجمّع السكنيّ بأكمله. وحالما لَمَحَ الضوء قد اشتعل، شرعَ يصيح عبر الباب.
“تذكرونني؟ ساعدتكم في قَطْر ثلّاجتكم من بريدنستروفي. تذكرتم؟ تحدّثنا عن باسترناك على الطّريق. لساعتين! قصفوا المشفى الليلة. أُختي ممرضة هناك. سرقتُ شاحنةَ شخصٍ وقُدتها عبر الحدود. لا أعرف أحدًا سواكم. أيمكنني أن أجري مكالمة؟”.
إذن، خَطَت الحرب بقدمها الحافية إلى طفولتي منذ عقدين، خلف قناعِ رجلٍ نصف عارٍ يلهث على الهاتف، ضحيّة حملة “إغاثة إنسانيّة” أولى بعد الحقبة السوفييتيّة.
2
خلال زيارة قريبة إلى أوكرانيا، اتّفقتُ مع صديقي الشّاعر بوريس خرسونسكي على اللقاء في مقهى قريب صباحًا للحديث عن باسترناك (وكأنّه كلُّ ما يتحدّث عنه الجميع في بقعتنا من العالم). ولكن حين وصلتُ الرّصيف عند التاسعة، كانت طاولات الرّصيف مقلوبةً، والرّكام متناثرًا في الشّارع من حيث مكان البناء الذي قُصف.
حشدٌ، بمن فيهم الصحافة المحليّة، تجمّعوا حول بوريس وهو يتحدّث شاجبًا القصف، ضدّ حملة إغاثة إنسانيّة زائفة أُخرى من حملات بوتين. البعض صفّقَ؛ وآخرون هزّوا رؤوسهم مستنكرين. بعد بضعة أشهر، قُصفت أبواب، وأرضيّات، وشبابيك شقّة بوريس.
أوكرانيا اليوم مكانٌ يُمتَحَن فيه الارتياب بالكتابة
ثمّة قصص كثيرة كهذه. وغالبًا ما تُتَبادَل بإيجاز، بعبارات عجولة، ومن ثمّ يتغيّر الموضوع فجأة.
يكتب أورويل: “كُتُب الحرب الحقيقيّة لا يستسيغها أبدًا من لم يحارب”.
حين يتساءل الأميركيّون عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، أفكّر بهذين السّطرين من قصيدة بوريس:
يحمل النّاس المتفجّرات عبر المدينة
في أكياس تسوّق بلاستيكيّة وحقائب صغيرة.
3
طوال السنوات العشرين الأخيرة، حَكَمَ أوكرانيا كلٌّ من الشّرق الناطق بالروسيّة والغرب النّاطق بالأوكرانيّة. تُكرّر الحكومة استخدام “قضيّة اللغة” للتّحريض على النّزاع والعنف، وهو إلهاءٌ فعّالٌ عن المشكلات الحقيقيّة القائمة. اندلع النّزاع الأخير استجابةً لسياسات الرئيس يانوكوفتش القاصرة، الذي فرّ إثره إلى روسيا. يُسلِّم الجميع بأنّ يانوكوفتش أكثر رئيس فاسد عرفته البلاد (أُدين بالاغتصاب والاعتداء، من بين جرائم أخرى، منذ الأيام السوفييتيّة). غير أنّ حكومة أوكرانيا الجديدة تُواصل هذه الأيام ضمَّ أوليغارشيّين وسياسيّين محترفين بأنساب عريقة ودوافع مشبوهة.
حين بدأت المواجهات بين حكومة يانوكوفتش وحشود المتظاهرين عام 2013، وفرّ الرئيس المحاصر من البلاد بعد فترة وجيزة، أرسل بوتين حشوده إلى القرم، وهي أرض أوكرانية، بحجّة حمايةٍ حماسيّةٍ للسكّان النّاطقين بالروسيّة. وسرعان ما ضُمَّت الأرض. وخلال بضعة أشهر، وبحجّة الإغاثة الإنسانيّة، أُرسلت قوّات عسكريّة روسيّة أكبر إلى أرض أوكرانيّة أخرى، دونباس، حيث اندلعت حرب بالوكالة.
طوال الوقت كانت حماية اللغة الروسيّة تُقتبَس دومًا بوصفها السّبب الأوحد للضمّ وللمشاحنات.
هل تحتاج اللغة الروسيّة في أوكرانيا إلى هذه الحماية؟ ردًا على احتلال بوتين، اختار أوكرانيّون كثيرون ينطقون بالروسيّة الوقوف مع جيرانهم النّاطقين بالأوكرانيّة، بدلًا من الوقوف ضدّهم. حين استعر النّزاع، وصلني هذا الإيميل:
“أنا، بوريس خرسونسكي، أعمل في جامعة أوديسا الوطنيّة حيث رأست قسم علم النّفس الإكلينيكيّ منذ عام 1996. كنتُ أدرّس بالرّوسيّة طوال تلك الأعوام، ولم يوبّخني أحدٌ قطّ على “تجاهل” اللغة الأوكرانيّة الرسميّة للبلاد. أُتقن الأوكرانيّة تقريبًا، غير أنّ معظم طلّابي يفضّلون المحاضرات بالروسيّة، ولذا أُحاضر بتلك اللغة.
أنا شاعر أكتب بالروسيّة؛ نُشرت معظم كتبي في موسكو وسان بطرسبورغ. ونُشر عملي البحثيّ هناك أيضًا.
وما تعرّضتُ أبدًا (هل تفهمني – أبدًا!) لهجوم لكوني شاعرًا يكتب بالروسيّة ولتدريسي بالروسيّة في أوكرانيا. أقرأ قصائدي في كل مكان بالروسيّة ولم أواجه أيّة تعقيدات على الإطلاق.
ولكنّي سألقي محاضراتي غدًا بلغة البلاد – بالأوكرانيّة. لن تكون محض محاضرة – ستكون فعلَ احتجاجٍ تضامنًا مع الدولة الأوكرانيّة. أدعو زملائي للانضمام إليّ في هذا الفعل”.
شاعرٌ يكتب بالروسيّة يرفض أن يُحاضِر بالروسيّة، وذلك تضامنًا مع أوكرانيا المحتلّة. ومع مرور الوقت، بدأت إيميلات مماثلة تصلني من شعراء وأصدقاء. كتب لي قريبي بيتر من أوديسا:
“أرواحنا قلقة، ونحن خائفون، لكنّ المدينة آمنة. أحيانًا ينهض بعض الحمقى ليعلنوا أنّهم يناصرون روسيا. ولكنّنا في أوديسا لم نقل لأيّ أحد إنّنا ضد روسيا. فليفعل الرّوس ما يحلو لهم في موسكوهم، وليحبّوا أوديسانا بقدر ما يرغبون – ولكنْ ليس بهذا السيرك من الجنود والدبّابات!”.
صديقة أخرى، الشّاعرة أنستازيا أفاناسييفا التي تكتب بالروسيّة، كتبت لي من مدينة خاركيف الأوكرانيّة بشأن حملة بوتين لـ “الإغاثة الإنسانيّة” التي شُنّت من أجل حماية لغتها:
“في السّنوات الخمس الأخيرة، زرت غربي أوكرانيا النّاطق بالأوكرانيّة ستّ مرات. ما شعرتُ أبدًا بتمييز ضدّي لأنّي أتحدّث بالروسيّة. تلك خرافات. في جميع مدن غربي أوكرانيا التي زرتها، تحدّثت إلى الجميع بالروسيّة – في المحالّ، في القطارات، في المقاهي. لقيتُ أصدقاء جددًا. وبدلًا من أن يشعروا باضطهاد، عاملني الجميع باحترام. أتوسّل إليك ألّا تنصت إلى البروباغندا. هدفها تفريقنا. إنّنا شديدو الاختلاف أساسًا، فلنعمل كيلا نصبح أضدادًا، كيلا نشنّ حربًا على الأرض التي نعيش فيها كلّنا معًا. الغزو العسكريّ الذي يحدث الآن هو الكارثة لنا كلّنا. فلنعمل كيلا نفقد عقولنا، كيلا نخشى تهديدات غير موجودة، حين يكون ثمّة تهديدٌ فعليٌّ: غزو الجيش الروسيّ”.
وأنا أقرأ رسالةً تلو أخرى، عجزتُ عن كبح تفكيري برفض بوريس التحدّث بلغته، بوصفه فعل احتجاج على الغزو العسكريّ. ما الذي يعنيه لشاعرٍ أن يرفض التحدّث بلغته؟
هل اللغة مكانٌ يمكنك مغادرته؟ هل اللغة جدارٌ يمكنك عبوره؟ ماذا يوجد في الجانب الآخر من ذلك الجدار؟
4
يرفض جميع الشّعراء استباحة اللغة. يُظْهِر هذا الرفض نفسه بصمتٍ يُضاءُ بمعاني المعجم الشعريّ – لا معاني ما تنطقه الكلمات، بل ما تكبته. وكما كتب موريس بلانشو: “أن تكتب يعني أن تكون مرتابًا بالكتابة بالمطلق، حينما تَهبُ نفسك لها كلّيّةً”.
أوكرانيا اليوم مكانٌ تُمتَحَن فيه عبارات كهذه. كاتبٌ آخر، جون بيرجر، يقول عن علاقة المرء بلغته: “للمرء أن يقول عن اللغة إنّها المنزل البشريّ الوحيد ربّما”، يُصِرّ على أنّها “المأوى الوحيد الذي لا يمكن أن يعادي المرء… في وسع المرء أن يقول للغة ما يشاء. ولهذا فهي مُنْصِتٌ، أقرب إلينا من أيّ صمتٍ أو أيّ إله”. ولكن، ما الذي يحدث حين يرفض الشّاعر لغته احتجاجًا؟
أو، لو طرحنا هذا السؤال ضمن نطاق أوسع: ما الذي يحدث للّغة وقت الحرب؟ سرعان ما تكتسب الإلهاءات سماتٍ ماديّة. هكذا ترى الشاعرة الأوكرانيّة ليودملا خرسونسكا جسدها وهو يراقب الحرب حولها: “مدفونةً في عنقٍ بشريٍّ، تبدو الرّصاصة مثل عينٍ، مخيطةٍ فيها”. حربُ الشاعرة كاترينا كاليتكو جسدٌ ماديٌّ أيضًا: “غالبًا ما تأتي الحرب وتستلقي بينكم كطفلٍ/ يخشى البقاء وحيدًا”.
قد تُغيّرنا لغة الشِّعر وقد لا تفعل، غير أنّها تكشف التغيّرات داخلنا: تكتب الشاعرة أنستازيا أفاناسييفا مستخدمةً ضمير جمع المتكلّم “نحن”، مُبيِّنةً لنا كيف أنّ احتلال بلدٍ يؤثِّر على جميع مواطنيه، بصرف النّظر عن اللغة التي ينطقونها:
حينما عربةٌ بمدفع هاون
عبرتِ الشّارع
لم نسأل من أنتم
على أي جانبٍ تميلون
سقطنا على الأرض وهَجَعْنا.
5
في زيارةٍ أخرى إلى أوكرانيا، صادفتُ جارًا سابقًا لي، وقد أقعدته الحرب الآن، يستجدي في الشّارع. كان حافيًا. حالما أسرعتُ الخطو، آملًا ألا يعرفني، ارتطمتُ فجأةً بيده الممدودة. كما لو أنّه يُودِعني حربه.
حينما خطوتُ مبتعدًا منه، حفّني شعورٌ غريبٌ من التّمييز. كم بدا صوته، أصوات الشّعراء الأوكرانيّين الذين تحدّثتُ إليهم، مشابهةً لأصوات النّاس في أفغانستان والعراق الذين دُمِّرتْ بيوتهم بأموال ضرائبي.
6
أواخر القرن العشرين، بات الشاعر اليهوديّ باول تسيلان شفيع الكتابة وسط الأزمة. مُدوِّنًا باللغة الألمانيّة، حطَّمَ الكلام ليعكس تجربة عالمٍ مستباحٍ جديد. هذا التأثير يحدث من جديد – في أوكرانيا هذه المرة – أمام أعيننا.
هاكم حالة الشاعرة ليوبا ياكيمتشوك التي تنحدر عائلتها من مدينة برفومايسك، إحدى الأهداف الأساسيّة لآخر جهود بوتين في “الإغاثة الإنسانيّة”. مُجيبةً عن أسئلتي بشأن خلفيّتها، قالت ليوبا:
ولدتُ وكبرتُ في منطقة لوهانسك التي مزّقتها الحرب، ومسقط رأسي برفومايسك مُحتلَّة الآن. شهدتُ في أيار/مايو 2014 بداية الحرب… وفي شباط/فبراير 2015، قرّر أبواي وجدّتي، الذين نجوا من الحرب المروّعة، الرحيل عن الأرض المحتلّة. رحلوا تحت وابل النّيران، ببضع حقائب ثياب. صديق لي، جنديّ [أوكرانيّ]، كاد يصيب جدّتي في رحلة الهرب.
مُناقِشةً الأدب وقت الحرب، كتبت ياكيمتشوك: “يتنافس الأدب مع الحرب، بل لعلّه يخسر أمام الحرب في الابتكار، وبذا يتغيّر الأدب بفعل الحرب”. في قصائدها، يرى المرء كيف أنّ الحرب تمزّق كلماتها: “لا تتحدّثوا إليّ عن لوهانسك”، تكتب، “لقد تحوّلتْ إلى هانسك منذ زمن بعيد/ لو سُوِّيَت بالأرض/ بالرّصيف القرمزيّ”. مدينة برفومايسك المقصوفة “قُسمت إلى برفو ومايسك”، وقذيفة ديبالتسيفو باتت اليوم “ديب، آلتس، إيفو”. وعبر موشور هذه اللغة المتشظّية، ترى الشّاعرة نفسها:
حدَّقْتُ بالأفق
… هرمتُ جدًا
ما عدتُ ليوبا بعد الآن
فقط – با.
وكما أنّ الشاعر خرسونسكي الذي يكتب بالروسيّة رفض النّطق بلغته حين احتلّت روسيا أوكرانيا، رفضت ياكيمتشوك، الشّاعرة التي تكتب بالأوكرانيّة، النّطق بلغةٍ غير متشظّية حينما تشظّت البلاد أمام عينيها. عندما تُغيِّر الكلمات، مُحطِّمةً إيّاها ومُطابِقةً الأصوات من داخل الكلمات، تُظهِر الأصوات معرفةً لا تمتلكها. ما عادتْ معجميّةً وإنْ ما تزال مفهومةً لنا، تواجه الكلمات المُحطَّمة القارئ بصمت، داخل اللغة وبمعزل عنها في آن.
حين يقرأ المرء قصيدة الشّهادة هذه، يُذكّر بأنّ الشِّعر ليس محض توصيفٍ لحدث؛ إنّه حدث.
7
ما شهادة هذا الشعر بالتّحديد؟ قد تغيّرنا لغة الشِّعر وقد لا تفعل، غير أنّها تكشف التغيّرات داخلنا. مثل جهاز رسم الزّلازل، تُدوِّن الأحداث العنيفة. عَنْوَنَ [تشيسواف] ميووش نصّه الأصيل “شهادة الشعر”: “لا لأنّنا نشهدها، بل لأنّها تشهدنا”. ومن مكانه في الجانب الآخر من السّتار الحديديّ، أخبرنا تسبغنييف هربرت أمرًا مماثلًا: “الشّاعر مثل بارومتر لنفسيّة الأمّة. لا يمكنه تغيير الطّقس. غير أنّه يُبيِّن لنا ماهيّة الطّقس”.
8
أيمكن لدراسة حالة شاعرٍ غنائيّ أن تُبيّن لنا أمرًا مشتركًا لدى كثيرين – نفسيّة أمّة؟ موسيقى زمن؟
كيف للعمود الفقريّ لشاعرٍ غنائيّ أن يرتعش مثل إبرة بارومتر؟ لعلّ هذا يكون لأنّ الشّاعر الغنائيّ إنسانٌ شديد العزلة: يخلق/تخلق في العزلة لغةً – موحيةً كفايةً، غريبةً كفايةً – تُمكِّنه/ها، من التحدّث، خفيةً، إلى أناس كثيرين في آن معًا.
9
كوني أعيش مئات الأميال عن أوكرانيا، بعيدًا من هذه الحرب، في فِنائي الخلفيّ الأميركيّ المريح، أيُّ حقٍّ لديّ لأكتب عن هذه الحرب؟ ولكن، أعجز عن كبح الكتابة عنها: أعجز عن كبح تأمّل كلمات شعراء بلادي بالإنكليزيّة، هذه اللغة التي لا ينطقونها. لمَ هذا الهوس؟ بين الجمل الصّمتُ الذي لا أملك سيطرةً عليه. ومع أنّها لغة مختلفة، الصمت بين الجمل هو ذاته: إنّه الفُسحة التي أرى فيها عائلةً ما تزال محتشدةً عند إطار الباب الساعة الرابعة فجرًا، يتجادلون ما إذا كانوا سيفتحون الباب للغريب الذي لا يرتدي إلا بنطلون البيجاما، ويصيح عبر الباب.
* Ilya Kaminsky شاعر أوكراني أميركي يكتب بالإنكليزية وهو صاحب مجموعة “الجمهوريّة الصمّاء”، التي وصلت إلى اللائحة النهائيّة لجائزة الكتاب الوطنيّ في الشعر عام 2019، ومؤلّف “الرّقص في أوديسا” و”موزيكا هومانا”. حظي شعره باهتمام عالمي وتُرجمت قصائده إلى لغات عديدة، ونُشرت كتبه في بلدان عدة. فقدَ كامنسكي معظم سمعه في سنّ الرابعة بعد نُكافٍ شُخّص خطأً على أنّه زكام. يشغل حاليًا منصب أستاذ كرسيّ بورن للشّعر. والمقالة مُقتطَفة من كتاب صدر بالإنكليزية عام 2017 بعنوان “كلماتٌ للحرب: قصائد جديدة من أوكرانيا”، وتُنشر ترجمتها في “العربي الجديد” باتفاق مع الشاعر.
العربي الجديد
—————————
الاجتياح الروسي لأوكرانيا: هل يبدل الغرب مقاربته للملف السوري؟/ أمين العاصي
تأمل المعارضة السورية أن يلعب التوتر المتصاعد بين الغرب وروسيا بسبب اجتياح جيش الأخيرة لأوكرانيا، دوراً في تحريك الملف السوري مجدداً، ودفع العالم الغربي إلى إعادة النظر في مقاربته “الرخوة” لهذا الملف، في سياق استراتيجية “أقصى الضغط” الذي يمارسه على موسكو.
وفي هذا الصدد، طالب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الإدارة الأميركية بـ”إعادة النظر في سياستها تجاه سورية”. وأشار إلى أن ما سمّاه “التراخي في مواجهة روسيا” سمح لموسكو بـ”تكرار العدوان على أوكرانيا اليوم”.
وقال رحمة، في بيان أمس الخميس، إن ما يحدث في أوكرانيا يجب أن يذكّر الجميع بما حدث ويحدث في سورية التي دمرها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، منذ بدء عدوانه العسكري في سبتمبر/أيلول 2015.
التدخل الروسي أدى إلى أكبر أزمة لجوء
وأضاف رحمة: على المجتمع الدولي أن يعرف جيداً أن التدخل الروسي في سورية، والقصف الهستيري الذي تعرضت له مدن وبلدات سورية، أدّيا إلى أكبر أزمة لجوء في القرن الحالي، وإلى دمار قد يكون هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان رئيس الائتلاف، سالم المسلط، قد قال، الثلاثاء الماضي، إن كسر شوكة الروس يبدأ من سورية عبر عودة الدعم السياسي والعسكري والإنساني الحقيقي للثورة السورية.
ومنذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من أسبوع، تنشط المعارضة السورية على صعد عدة، للمطالبة بدعم كبير لها من أجل الضغط السياسي والعسكري على الروس والنظام في سورية.
وكان من المقرر أن تُعقد أمس الخميس اجتماعات “تنسيقية” في العاصمة الأميركية واشنطن، دعا إليها مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية إيثان غولدريش، تضم مبعوثي عدد من الدول الأوروبية والعربية والاتحاد الأوروبي، ما فُسر على أن الأميركيين يضعون خططاً للضغط على الروس في الملف السوري. وتندرج هذه الاجتماعات في سياق استراتيجية “أقصى الضغط” التي اعتمدها الغرب على بوتين.
الأزمة الأوكرانية فرصة لتغيير المقاربة لسورية
ومن الواضح أن المعارضة تعتبر الأزمة الأوكرانية فرصة مهمة لتغيير مقاربة الغرب للملف السوري، التي تُوصف بـ”الرخوة”، ما سمح للروس والإيرانيين بالسيطرة على كل مفاصل القرار السوري.
وتعتبر المعارضة الوجود الروسي في سورية بمثابة “احتلال مباشر”، لكنها اليوم عاجزة عن مواجهته بسبب نقص السلاح النوعي والذخيرة والغطاء السياسي الكافي.
واكتفت الولايات المتحدة بدعم “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد في شمال شرق سورية، متخلية عن فصائل المعارضة السورية “المعتدلة”، التي تعتمد على دعم تركي لها في مناطق سيطرتها في شمال سورية.
واستفاد الروس من تراخي الغرب في الملف السوري في الهجوم الجوي على فصائل المعارضة، ما أدى إلى انسحاب هذه الفصائل من جل المناطق التي كانت تحت سيطرتها في جنوب البلاد ووسطها وجانب من شمالها.
وقضمت قوات النظام بدعم روسي كبير جنوب سورية، بما فيه محيط دمشق، ومناطق في ريفي حمص وحماة وسط البلاد، وجانباً من أرياف إدلب وحلب واللاذقية. واعتمد الروس سياسة “نزع أوراق الضغط” من يد المعارضة السورية، التي انحصر وجودها في بقع جغرافية ضيقة في شمال سورية، وهي اليوم مكبّلة غير قادرة على تغيير خريطة السيطرة بسبب التفاهمات التركية الروسية.
وتفرد الروس بالملف السوري، ما أدى إلى عرقلة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ما سمح للنظام بالتملص من تنفيذ القرار الدولي رقم 2254 الذي نص على تحقيق انتقال سياسي جاد في سورية.
المعارضة تبحث عن سلاح “نوعي”
وتبحث فصائل المعارضة السورية عن سلاح “نوعي” يمكن أن يحرك الجبهات “النائمة” مع النظام وداعميه الروس والإيرانيين.
وأكد الرائد يوسف حمود، وهو من قياديي فصائل المعارضة السورية، أن هذه الفصائل “قادرة على المواجهة وإسقاط النظام لو امتلكت سلاحاً يردع الطيران الروسي”، مضيفاً: “لولا تدخل الروس في عام 2015 لكان النظام قد سقط”.
من جهته، أشار المتحدث باسم هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية يحيى العريضي، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “كل الاحتمالات مفتوحة” حول تلقي المعارضة دعماً غربياً.
وقال: العالم يتمترس حول أوكرانيا، ويسعى لخنق جموح بوتين حامي منظومة الاستبداد. وتابع: المساعي الدولية لتعطيل أذرع بوتين الخارجية، وربما نفوذه في سورية واحد منها، قد ينعكس إيجاباً على القضية السورية، عبر دعم يُقدَّم لمقاومة “النظام” وحُماته.
وبيّن العريضي أنه “من جانبنا، نحن كأعضاء مستقلين في الهيئة، أرسلنا كتاباً للاجتماع المنعقد في واشنطن لدول أصدقاء سورية، نوضح رفضنا لمبدأ الخطوة بخطوة، وطالبنا بالعودة لدعم الشعب السوري لمواجهة استبداد النظام وحُماته، والتطبيق الحرفي والفعلي للقرار 2254”.
وحصلت “العربي الجديد” على نسخة من “نداء وتحية لأصدقاء الشعب السوري”، الذي وجهه أعضاء مستقلون في هيئة التفاوض، أشاروا فيه إلى أن “روسيا جربت 300 صنف من أسلحتها على السوريين”.
ولفتوا إلى أن موسكو استخدمت حق النقض في مجلس الأمن 15 مرة “لتعطيل أي إنصاف للشعب السوري”. وقالوا في البيان/ النداء: روسيا استمرت بالشراكة مع النظام في تشويه القرار الدولي 2254 بتحويله إلى سلل، ثم اختصاره باللجنة الدستورية. وطالبوا بـ”وضع حد للتغول الروسي في القضية السورية… وعدم الخروج عن التطبيق الحرفي للقرار الدولي 2254″.
لا تغيير جوهريأً بشأن سورية
وفي السياق، استبعد المحلل السياسي رضوان زيادة، في حديث مع “العربي الجديد”، أي تغيير “جوهري” في موقف الغرب من القضية السورية. وقال: “قد يكون هناك تركيز إعلامي لا أكثر على جرائم روسيا في سورية من أجل إحراجها”.
استبعد رضوان زيادة أي تغيير “جوهري” في موقف الغرب من القضية السورية
واستبعد تماماً أن يزوّد الغرب فصائل المعارضة السورية بأسلحة نوعية، موضحاً أن “هذا الأمر غير مطروح، وليس لدى الولايات المتحدة رغبة في إعادة فتح ملف التسليح في سورية”.
وتابع: “واشنطن تعتبر وقف تصعيد العنف في سورية أفضل الحلول الممكنة بعد صعوبة الوصول إلى حل سياسي عبر تطبيق القرار الدولي 2254، الصادر أواخر عام 2015. عدم تجدد العنف يبقى الخيار الأفضل لواشنطن وحلفائها الأوروبيين”.
العربي الجديد
—————————-
غرائب وعجائب في مقر الأمم المتحدة على هامش الأزمة الأوكرانية/ عبد الحميد صيام
كأننا هنا أمام مسرح اللامعقول. تتبدل الأدوار ويصبح منتهكو القانون الدولي أمس، حمامات سلام اليوم. ممثلون يغيرون ملابسهم وأدوارهم. فمن لعب دور الشرطي في فيلم سابق، يلعب الآن دور الناسك، ومن انتهك الميثاق مرارا وتكرارا في الماضي، يذرف الدموع الغزيرة على انتهاك الميثاق في الحاضر، خرج قبل فترة وهو يحمل مسدسا، وعاد إلى المسرح وهو يلبس مسوح الرهبان.. كان يدافع عن تصيده للأبرياء، والآن يدعو لحمايتهم ويطالب بالتهدئة والحكمة. تتغير الأدوار والأصوات والملابس ونبرات الصوت وجوهر المسرحية واحد. وأود أن أشارك القراء في مجموعة ملاحظات تثير الغثاء حينا، والاستهجان والتعجب أحيانا. وتسأل هل في عالم اليوم مكان للمبادئ والعدالة، والقانون الواحد المنطبق على الجميع من دون استثناء؟
احترام الميثاق
جميل جدا أن يسمع الإنسان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، تتحدث عن انتهاكات روسيا للقانون الدولي، وعدم احترام ميثاق الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا، الدولة العضو في الأمم المتحدة، التي تتمتع بالسيادة ضمن حدود دولية معترف بها. كلام جميل لا غبار عليه. فما من شك لا من قريب ولا من بعيد، بأن روسيا انتهكت القانون الدولي بغزوها لأوكرانيا صباح الخميس الفائت 24 فبراير. جريمة العدوان منصوص عليها في القانون الدولي، وقد أخذت الدول الأعضاء نحو 30 سنة حتى اتفقوا على تعريف ما هي جريمة العدوان، في القرار 3314 بتاريخ 10 ديسمبر 1974. لكنهم لم يتفقوا لغاية الآن على تعريف الإرهاب.
السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، في رده على سرب الناعين على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد على الميثاق نفسه، ليبرر عدوانه على أوكرانيا، مشيرا في كلمته إلى أن ما تقوم به بلاده يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى البند 51 المتعلق بحق الدفاع عن النفس. يذكرني هذا الوضع وهذه الضجة غير المسبوقة في الأمم المتحدة، ربما منذ الحرب العالمية الثانية، بمقولة للأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي، عندما قارن بين حربي الصومال ويوغسلافيا قائلا، إن هناك فرقا بين تعامل المجتمع الدولي بين حرب الفقراء وحرب الأغنياء. وما نأمله من هذه الأزمة، التي ما زالت تسيطر على مداولات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، اعتبارا من يوم الخميس 3 مارس ومطروحة على جدول أعمال محكمة العدل الدولية، أن تعيد الاعتبار لأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
طرد روسيا
السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، أثار في جلسة مجلس الأمن الجمعة بعد استخدام روسيا للفيتو، ضرورة طرد روسيا من مجلس الأمن، باعتبارها في حالة انتهاك للقانون الدولي والميثاق. تلاسن مع السفير الروسي نيبنزيا، الذي سفّه هذه الفكرة، لكن السفيرة البريطانية باربرا وودورد، قفزت إلى الواجهة لتؤيد طرد روسيا من مجلس الأمن، وتعبر عن مكنون أحلامها في عودة إمبراطوريتها الآفلة إلى صناعة أحداث العالم. امرأة تتكلم وعيناها مليئتان غضبا وحقدا لم تستطع أن تخفيهما.
تصويت الإمارات بامتناع
من غرائب الأمور أن الإمارات العربية المتحدة صوتت مرتين بـ»امتناع» في مجلس الأمن، الجمعة لإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، والأحد لدعوة الجمعية العامة لعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة العدوان الروسي على أوكرانيا. وقد استغرب الكثيرون هنا هذا الموقف، كونه لا ينسجم مع سياسة الدولة الحليف الدائم للولايات المتحدة، الدولة التي تأخذ عادة مواقفها، وفي ذهنها موقف الولايات المتحدة مثل الانضمام لحملة «عاصفة الصحراء» عام 1991 وعملية «حرية العراق» 2003 والحرب على اليمن 2015 وغير ذلك الكثير. نتفهم موقفي الصين والهند في التصويت بـ»امتناع» لأسباب كثيرة من بينها تشابك المصالح بين روسيا والدولتين، لكن موقف الإمارات أثار كثيرا من الاستهجان. تبرير مندوبة الإمارات العربية لانا نسيبة لهذا الموقف، يدور حول الالتزام بالتسوية السلمية، ورفض استخدام السلاح وغير ذلك لم يكن مقنعا. فجاء التفسير الصحيح يوم الاثنين عند مناقشة بند اليمن في مجلس الأمن.
تصويت روسيا مع قرار تصنيف الحوثيين حركة إرهابية
جاء التصويت يوم الاثنين 28 فبراير على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وبدعم من الإمارات مفاجئا للعديدين. فقد تضمن القرار تطورين مهمين في مداولات مجلس الأمن في القضية اليمنية. أولا وسم الحركة الحوثية بالإرهاب، وهو ما لم يحدث من قبل. صحيح أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، صنف الجماعة بأنها حركة إرهابية في الأيام الأخيرة من ولايته، لكن الرئيس بايدن ألغى ذلك التصنيف. والتصنيف بأنها حركة إرهابية، ذكر بالتحديد الهجمات الصاروخية، أو عن طريق المسيرات ضد أهداف خارج حدود اليمن تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات.
والبعد الجديد الذي أضافه القرار الجديد هو تعميم العقوبات، ليس على أفراد في الحركة الحوثية، كانوا قد ذكروا بالاسم في القرارات السابقة، بل على كل الحركة الحوثية في اليمن. لكن المفاجأة جاءت في تصويت روسيا لصالح القرار، وتصويت كل من المكسيك وإيرلندا والنرويج والبرازيل، بـ»امتناع» وهي دول لا شك في أنها أكثر انحيازا للموقف السليم والحيادية في موضوع اليمن. فكيف يتم ذلك؟ كيف لروسيا الداعمة لإيران الداعمة للحوثيين، أن تتصرف بهذه الطريقة ضد مصالح حليفتها طوال هذه السنين. إذن من الواضح أن هناك مقايضة جرت، وثمنا دفع. فمقابل «امتناع» الإمارات مرتين في المجلس، صوت المندوب الروسي بـ»نعم» للقرار 2624 (2022). ومتابعة للموضوع فالإمارات عادت وصوتت يوم الأربعاء بـ»نعم» لصالح مشروع قرار إدانة الغزو الروسي في جلسة الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة. قال لي زميل صحافي: «أخذت السفيرة ما تريد من الروس والآن تعود إلى موقعها التقليدي». الدول الأربع التي صوتت بـ»امتناع» بررت مواقفها بأن ليس هناك تعريف متفق عليه لمصطلح الإرهاب: نائبة سفيرة إيرلندا قالت: «أعربنا عن قلقنا إزاء إدخال وسم إرهابيين على النص. لا نزال قلقين من استخدام مثل هذه المصطلحات، في غياب تعريف واضح لها، قد يكون له تأثير سلبي في جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.»
الكويت ـ إسرائيل
نتفهم تماما موقف الكويت من الاصطفاف خلف الولايات المتحدة في رفض غزو أوكرانيا، فما من بلد مؤهل للحديث عن مرارة الغزو الخارجي والمآسي التي يجرها على البلاد والعباد أكثر من الكويت. ولذلك تفهمنا وقوف السفير الكويتي منصور العتيبي، ضمن مجموعة من السفراء الذين وقفوا أمام قاعة مجلس الأمن يوم الجمعة، بعد استخدام السفير الروسي للفيتو، الذي أطاح بمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وألبانيا لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد وقفت محاطة من جانبيها وخلفها بأكثر من 40 سفيرا وشجبت استخدام روسيا للفيتو، وأكدت أن مشروع القرار يحظى بغالبية ساحقة من الدول الأعضاء، وأكدت عزلة المندوب الروسي، الذي لم يجد ولا دولة واحدة تقف إلى جانبه في هذا الموقف. السؤال الذي طرحه المراقبون هنا من صحافيين ودبلوماسيين، كيف تجرأ السفير الإسرائيلي جلعاد إردان، على التغيب عن هذه اللمة حول السفيرة الإسرائيلية؟ بل لم يكن من بين نحو 82 دولة أضافت اسماءها لرعاية مشروع القرار. إسرائيل تغيب عن مهرجان تقوده الولايات المتحدة. «أليس في الأمر إن» كما يقال؟ أي هل الموضوع متفق عليه؟ أم أن مصالح إسرائيل مع روسيا تكاد توازي مصالحها مع أمريكا؟ لكن إسرائيل عادت وصوتت لصالح قرار الجمعية العامة مثلها مثل الإمارات.
الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة
هذه الدورة الاستثنائية الطارئة رقم 11. يعني سبقها عشر دورات. جزء كبير منها عن فلسطين. والدورة العاشرة كانت لها علاقة بالممارسات الإسرائيلية. عقدت عام 1997 وبقيت مفتوحة لغاية سنة 2018، حيث عقدت جلسة عن القدس بعد قرار ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة موحدة ودائمة لإسرائيل يوم 6 ديسمبر 2017. طرح مشروع قرار في مجلس الأمن للتأكيد على وضعية القدس، ورفض قرار ترامب. تم التصويت عليه يوم 18 ديسمبر 2017 فحصل على 14 صوتا إيجابيا وكان تصويت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي هو الصوت السلبي الوحيد، الذي أجهض مشروع القرار. بعد ذلك نقلت المسألة للجمعية العامة فصوتت عليه أغلبية الثلثين: 128 صوتا ومعارضة 9 ضد و35 امتناعا. أمريكا يومها كانت معزولة ولم تجد إلى جانبها إلا حفنة من الدول مثل روسيا اليوم. يومها كان قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لا قيمة له عند المندوبة الأمريكية، أما هذه المرة فقرار الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة عند المندوبة الأمريكية فتاريخي ومهم وملزم ويصل في مستواه إلى قرار مجلس الأمن، لأنه اعتمد تحت آلية «متحدون من أجل السلام». هكذا تتصرف الدول الكبرى- تتبادل الأدوار عند اختلاف المصالح. وكان الله بعون الدول الصغيرة والفقيرة.
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي
القدس العربي
——————————-
من كوبا 1962 إلى أوكرانيا 2022: شبح حرب عالمية ثالثة “نووية”/ شوقي بن حسن
مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا منذ أسبوع، عادت إلى واجهة الخطاب السياسي العالمي مفرداتٌ اعتقدنا أنها طُويت مع القرن العشرين، إذ عاد الحديث بقوة عن ضرورة التسلّح والتهديد بالسلاح النووي، ومن ثمّ نشطت مفردة “الحرب العالمية” بشكل واضح، كما لم يحدُث منذ زمن طويل، منذ نحو ستين عاماً، أي مع أزمة الصواريخ في كوبا.
وفي تلك الأيام من أكتوبر/ تشرين الأول 1962، حبس العالم أنفاسه مع تصاعد حدّة خطاب الرئيس الأميركي جون كينيدي، وهو يشير إلى انتهاكات الاتحاد السوفييتي للفضاء الحيوي لبلاده. وكانت طائرة تجسّس أميركية قد التقطت صورة تُبرز وجود منصّات إطلاق رؤوس نووية على الجزيرة وصلت إليها من موسكو، وأخرى بانتظار الوصول.
وبالنسبة للأميركيين، يعني حضور السلاح الروسي على مسافة لا تزيد عن 200 كيلومتر أنه من غير الممكن التصدّي لأي هجوم سوفييتي يتخذ من كوبا منصّته، حيث لا تستطيع المنظومة الدفاعية إيقاف الصواريخ إلا بعد أن تكون قد دمّرت جزءاً غير هيّن من المواقع الحيوية. وقد برّر ذلك للأميركيين التحرّكَ بفرض حصار بحريّ كامل على الجزيرة.
ما أشبه أوكرانيا بكوبا. صحيح أنه لم تظهر صورٌ تبّين وجود صواريخ أميركية، لكن موسكو تعلم أن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعني أن هذا السيناريو سيكون ممكن التنفيذ، ووقتها، ستكون روسيا في نفس موقع الولايات المتحدة الأميركية عام 1962، ومن هنا قرّر بوتين وجنرلاته أن تكون حربهم استباقية بمنع دخول أرض أوكرانيا ضمن الحلف وإزعاجه من موقع هجومي.
يُذكر أن واشنطن، في 1962، لم تكتف بحصار كوبا، بل حرّكت قواعد صواريخها في تركيا، باعتبارها أقرب أرض تابعة لتحالف “الناتو” من روسيا. وكان لتلك الخطوة مفعول ردعيّ واضح، فقد انتقل مسار الأحداث من التهديد بالحرب النووية إلى مسارات دبلوماسية أفضت إلى اتفاقيات أنهت “أزمة الصواريخ”، وبات العالم يحتفظ بوقعها النفسي أكثر من أي أثر آخر.
وأفضت تلك الاتفاقيات إلى فك الحصار البحري ضدّ كوبا (بما أن حصاراً اقتصادياً كان قائماً واستمر لعقود) مقابل سحب الاتحاد السوفييتي منصّاته من أرض الجزيرة، وانتزع نيكيتا خروشوف أيضاً تعهّداً أميركياً بعدم غزو كوبا، وهو ما أتاح لنظام كاسترو أن يستمر رغم التحرّش الدائم للجار الأميركي، كما جرى الاتفاق على تطوير قنوات الحوار بين القطبين، وهو ما أعفى العالم من أزمات شبيهة.
ومرّت عقود طويلة على تلك الأزمة، عقود جعلت من الصراع الروسي-الأميركي مجرّد “حرب باردة” بعيدة عن كل احتكاك أو تهديد مباشر، حتى إذا تفكّك الاتحاد السوفييتي بداية تسعينيات القرن الماضي، قيل إن ما حدث في كوبا ذات يوم لن يتكرّر أبداً.
حرب عالمية ثالثة “نووية”
لكن ها هو فلاديمير بوتين يوقظ “المارد النووي” من جديد، بعد أن تباطأ تقدّم دباباته في أوكرانيا ودخول أوروبا وأميركا معاً في عملية تصعيد ضدّ نظامه بفرض عقوبات اقتصادية قاسية، لا أحد يعلم عواقبها مع شخصية مثل بوتين، الذي يشير كثيرون إلى أنه ليس ممن يُحبّذ “اختبار حلمه”، ومع كل خطاب للرئيس الروسي، بات العالم يحبس أنفاسه.
وحتى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوّح بأن “أسلحة نووية ستستخدم، وسيحل دمار واسع إذا نشبت حرب عالمية ثالثة”.
من جهة أخرى، ها هي ألمانيا، ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تعود إلى المنطق العسكري. ففي خطابه يوم الأحد الماضي أمام البوندستاغ، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن ضرورة أن يكون لألمانيا جيش مقاتل يستطيع مواجهة الخطر الروسي الكامن، مشيراً إلى كون اجتياح أوكرانيا “ليس إلا مقدّمة لابتلاع أوروبا”.
شبح الحرب العالمية يعود للذاكرة
وخطاب كهذا لا يمكن إلا أن يعيد للذاكرة صراعات الحرب العالمية الثانية. كان مسارها في الاتجاه المعاكس (من ألمانيا إلى روسيا)، وبدايتها شبيهة بما يحدث اليوم، فقد كانت شرارتها حين اجتاح النظام النازي بولندا (حليفة فرنسا وبريطانيا) في 1939 تأميناً للأقليات الناطقة بالألمانية، والأمر ليس بعيدا عن الذرائع الروسية في شرق أوكرانيا.
وكما لم تُفد معاهدات السلم طويلة الأمد بين أدولف هتلر وجوزيف ستالين في وقف الحرب، فإن “بروتوكول مينسك” (2014) الذي وُضع لمنع أي غزو روسي لأوكرانيا ليس سوى حبر على ورق إذا كانت المصلحة تقتضي غير ذلك.
وحين اشتعلت “أزمة الصواريخ الكوبية” في 1962، كانت ذاكرة العالم حديثة العهد بالحرب العالمية، إذ لم تمر سوى 17 عاماً على نهاية نسختها الثانية، ولذلك كان الخوف على أشدّه، ولا ننسى أن الحرب الأولى قد دارت ما بين 1914 و1918، أي على مسافة عقدين من الثانية. فحين ظهرت أزمة كوبا، بدا للبعض أن العالم لا يستطيع أن يضمن السلام الدولي أكثر من عقدين.
ويعود العالم هذه المرة إلى شبح الحروب العالمية بعد أن عاش عقوداً طويلة من الاستقرار النسبي. ولم تنته الحروب- طيلة ثمانية عقود- لكنها باتت محدودة الانتشار، أو تدور بالوكالة، غير أن حرب بوتين هذه المرّة تعيد العالم إلى اختبار السير فوق الهاوية.
————————–
الصين… الملاذ الروسي الأخير/ أحمد ذكر الله
تنهمر العقوبات الأميركية الأوروبية على روسيا دونما توقف، هادفة إلى توجيه مجموعة متنوعة من الضربات القاصمة للاقتصاد الروسي والعمل على الزج به خارج أطر العمل الدولي وحشره في الزاوية حتى الاستسلام، انطلاقا من أدوات الهيمنة الاقتصادية والمالية العالمية التي بنيت خلال الخمسين عاما الماضية والتي تشكل أدوات تحكم عن بعد، تمسك بمفاتيحها الدول الكبرى، والتي تكبد المارقين عن الأطر المرسومة بدقة خسائر فادحة، ربما تستطيع الدول تحملها لبعض الوقت، ولكن المؤكد أنها لن تستطيع الاستمرار في التحمل بدون تكاليف باهظة وفي مقدمتها فقدان المناصرين والداعمين حتى من الداخل.
ولا شك أن استخدام تلك العقوبات يعد أسلحة اقتصادية مدمرة، لن تدفع الاقتصاد الروسي فقط نحو الركود العميق، ولكنها في الأساس تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي، وربما مستقبل تماسك الدولة الروسية بأكملها، ولا يعد ذلك من قبيل المبالغة، فالدول التي تفرض العقوبات تمثل نصف اقتصاد العالم، وتستخدم كل المتاح لديها من أدوات القوة الاقتصادية، ضد دولة تمثل فقط 2% من الاقتصاد العالمي.
أهم العقوبات الاقتصادية على روسيا
تعددت العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي جراء الغزو لأوكرانيا، وكان أهمها العقوبات التي فرضت على البنك المركزي والصناديق السيادية الروسية، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية العالمية، وتجميد أصول الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وإدراج سيرغي شويغو وزير الدفاع، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما استهدفت العقوبات كذلك تجميد أصول الشركات الكبرى المملوكة للدولة الروسية بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع والعمل على تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو لشركات روسية، علاوة على منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
كذلك أقر الاتحاد الأوروبي الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي” الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية، كم فرضت عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم.
وكانت أخطر هذه العقوبات إعلان المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، فرض عقوبات إضافية على روسيا، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمائة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود، كل ذلك بالإضافة إلى العقوبات التي اتخذتها بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا والتي قيدت دخول السفن الروسية لموانئها، وحظر تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية، ومنع المواطنين والشركات من أي تحويلات مالية نحو روسيا.
تنامي التعاون الاقتصادي الروسي الصيني
من المنطقي بعد توجيه الغرب لترسانة أسلحته الاقتصادية نحو الاقتصاد الروسي أن تبحث روسيا عن حلفاء محتملين يساعدونها على تخطي بعض من تداعيات تلك العقوبات، ويبرز التنين الصيني الصاعد كأهم حليف يمكن الاستناد إليه في المرحلة الراهنة، خاصة أنه يعد هو الآخر مارقا من وجهة النظر الأميركية، مما استوجب فرض مجموعة متنوعة من العقوبات ضده، بالإضافة إلى التاريخ والتعاون الاقتصادي المشترك بين الدولتين لا سيما على صعيد تصدير الغاز.
فمن ناحية أصبحت الصين المستورد الأكبر للغاز الروسي وذلك بعد استكمال عدة خطوط لنقل الغاز الروسي عبر سيبيريا، وهو ما أفلت احتياجات الصين من الغاز من القبضة الأميركية التي تتحكم في الطرق البحرية التي كانت تمر منها سابقا 80% من الواردات الصينية عبر مضيق ملقا، كما ساعد الروس ولو نسبيا على تنويع أسواق التصدير كبديل لشبه الاحتكار الأوروبي لصادراتهم من الغاز.
كما أن مؤشرات العلاقة الاقتصادية بين الجانبين تسير في اتجاه إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في الأطر الإقليمية التي ينتميان إليها، ويبرز ذلك بتوقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية، والتعاون الرقمي، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الداخلية والمشتركة، وتعزيز قطاع المشاريع المالية المشتركة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العمال الصينين الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية الروسية.
وهو الأمر الذي أثمر عن زيادة كبيرة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث أظهرت بيانات هيئة الجمارك العامة الصينية نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين خلال عام 2021 بنسبة 35.8 في المائة لتبلغ 146.88 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 33.8 في المائة على أساس سنوي وبلغت 67.565 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 37.5 في المائة لتبلغ 37.5 مليار دولار.
بالإضافة إلي توفير روسيا ما يقارب 40% من احتياجات الغاز الصينية، والتوافقات البينية والمشتركة بين البلدين في الكثير من القضايا والملفات، بالإضافة إلى أن الصين كانت المحطة الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين في مطلع فبراير/شباط الماضي قبل غزو أوكرانيا بقليل، وتوقيعه لاتفاقيات متنوعة تصل قيمتها لحوالي 117 مليار دولار، كل ما سبق دفع العديد من الباحثين للقول بأن الصين ربما تشكل الملاذ الأخير المحتمل لروسيا لتخفيف وطأة الحرب الاقتصادية الأوروأميركية.
الملاذ الصيني ليس مؤكداً
من الواضح أن بكين لن تدعم أي عقوبات ضد موسكو وستظل شريكة لها، ولكن السؤال هل ستواصل الصين تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا بما يضمن تخفيض فواتير العقوبات، ووفقا للمحللين الروس فإن موسكو تأمل أن يتفهم الصينيون أن دورهم قادم، وأن مساعدتهم روسيا جزء من دفاعهم عن أنفسهم، وأن الصورة التي يصدرها الغرب أن العالم كله يواجه روسيا ليست إلا مبالغة إعلامية غربية، حيث الواقع أن روسيا تواجه فقط أوروبا والولايات المتحدة، فهناك أيضا دول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كما أنه من الواضح، طبقا للمحللين الروس، أن الصين وبقية دول منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قادرة بتعاونها معا، على التخلي عن نظام بريتون وودز والدولار، وتأسيس نظام خاص بها، وبعد ذلك ستكون هناك منافسة بين النظامين، وسيحدد الزمن أيهما أكثر استقرارا.
تعبر الأمنيات الروسية السابقة عن مكنون الفكر الروسي حول الخروج من الأزمة، ولكن السؤال الأهم يدور حول واقعية الطرح الروسي واستعداد التنين الصيني للمواجهة في الوقت الراهن لا سيما أن هذا الاستعداد لم يتجل في تصريحات رسمية بعد، كما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ في آخر محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي منذ أيام، صرح بعدة عبارات مطاطة قائلا: “إنه يجب في الأزمة الأوكرانية، التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول”، كما أكد أن الجانب الصيني يؤيد التسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات، بما يعني أن الصين لم تقرر التوغل في المستنقع الحالي على الأقل في الفترة القصيرة القادمة.
حرب أوكرانيا بداية لنظام عالمي جديد
اتفق معظم الخبراء أن يوم بداية الحرب على أوكرانيا كان إيذانا ببداية تشكل نظام عالمي جديد، وأيا كان الترجيح حول جر روسيا إلى الحرب لاستنزافها أو قدرات الدب الروسي على الصمود، سيبقى الحليف الصيني المحتمل قوة رافعة لروسيا في مواجهة استنزاف العقوبات الاقتصادية المنهمرة، بالإضافة إلى إمكانات اتحادهما في تشكيل ذلك النظام العالمي الجديد.
وسيبقى العجيب في الأمر استسلام الدول العربية لوقائع الأحداث وعدم استثمار الفرص التي تخلفها ساحات الحروب في شغل أحد مقاعد الفواعل الدولية، أو على الأقل تعظيم مكاسبها من خلال الانحياز لأحد الطرفين، وعموما فقد تأكد من جديد أن مصالح الشعوب العربية تختلف تماما عن مصالح أنظمتها، وهو الأمر الذي جعل هذه الشعوب تابعة للنظام العالمي القديم وعلى الأرجح الجديد.
العربي الجديد
————————————
عقوبات أميركية بالجملة على النخب الروسية..لا مكان للاختباء
أضافت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة، أكثر من 90 منظمة وفرداً إلى قائمة قيود التصدير المفروضة والمحظورة على روسيا بسبب غزة أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة إنه تم “تعديل لوائح إدارة التصدير لإضافة 91 عنصراً جديداً إلى القائمة وفقا لما جاء في إشعار السجل الفيدرالي، الذي سيتم نشره رسميا ويدخل حيز التنفيذ في 9 آذار/مارس”.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة استهدفت، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، أفراداً إضافيين من النخبة الروسية وأفراد أسرهم الذين يواصلون دعم الرئيس فلاديمير بوتين على الرغم من غزوه “الوحشي” لأوكرانيا.
وأضاف بيان وزارة الخزانة “لقد جمع هؤلاء الأفراد ثرواتهم على حساب الشعب الروسي، وأوصل البعض منهم أفراد عائلاتهم إلى مناصب رفيعة. ويتربع آخرون على رأس أكبر الشركات الروسية وهم مسؤولون عن توفير الموارد اللازمة لدعم غزو بوتين لأوكرانيا”. وذكر إنه “سيتم فصل هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم عن النظام المالي الأميركي وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وحظر ممتلكاتهم. وستتبادل وزارة الخزانة الاستخبارات المالية والأدلة الأخرى عند الاقتضاء مع وزارة العدل بغرض دعم الملاحقات الجنائية ومصادرة الأصول”.
وأشار البيان إلى أن أحد النخب الذي فُرضت عليهم العقوبات “هو أليشر برهانوفيتش عثمانوف، وهو أحد أغنى الروس وحليف مقرب لبوتين”. وأوضح أنه “سيتم حظر ممتلكاته من الاستخدام في الولايات المتحدة ومن قبل المواطنين الأميركيين، بما في ذلك يخته الذي يعد أحد أكبر اليخوت في العالم وقد صادرته ألمانيا، وطائرته الخاصة التي تعد إحدى أكبر الطائرات المملوكة للقطاع الخاص في روسيا”.
كما فرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على ديميتري بيسكوف وهو متحدث باسم بوتين وأحد كبار ممولي دعايته. إضافة إلى قيود على منح التأشيرات ل19 فرداً من الأوليغارشية و47 فرداً من أفراد أسرهم وشركائهم المقربين.
وتعليقاً على العقوبات، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستبقى متحدة مع حلفائها وشركائها في التزامها بضمان أن تدفع حكومة روسيا ثمناً اقتصادياً ودبلوماسياً باهظاً لعدوانها على أوكرانيا. واعتبر أن هذه الإجراءات “توضح أنه لا مكان يختبئ فيه الأفراد والكيانات الذين يدعمون حرب روسيا المروعة ضد أوكرانيا”.
واستهدفت الإجراءات الأميركية المدراء التنفيذيين الروس المؤثرين أمثال رئيس “ترانسنفت” نيكولاي توكاريف؛ والرئيس التنفيذي لشركة “روست” سيرغي تشيميزوف؛ ورئيس “في إي بي آر أف” إيغور شوفالوف.
وأشار إلى أن العقوبات على بيسكوف تأتي في إطار استهداف المتورطين في حملة التضليل والتأثير المزعزعة للاستقرار التي تشنها روسيا.
كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أفراد النخبة الروسية يفغيني بريغوزين (طباخ بوتين) الذي سبق إدراجه بموجب سلطات عقوبات مختلفة. وأضاف زوجة بريغوزين، بولينا وابنته ليوبوف وابنه بافيل، الذين يلعبون أدواراً مختلفة في مشروعه التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج 26 فرداً وسبعة كيانات مرتبطة بحملة التضليل الروسية الدولية، ولا سيما تلك المدعومة من قبل أجهزة المخابرات الروسية.
وتستخدم هذه الأهداف المنظمات التي تزعم أنها تعمل كمواقع إخبارية شرعية، ولكنها بدلاً عن ذلك تنشر معلومات مضللة ودعاية قومية متطرفة للاتحاد الروسي، بحسب بيان بلينكن.
كما فرضت وزارة الخارجية “تكاليف باهظة” على شركات الدفاع الروسية من خلال فرض عقوبات على 22 شركة مرتبطة بالدفاع. وتستهدف هذه العقوبات القوية كيانات تطور وتنتج طائرات مقاتلة ومركبات قتال مشاة وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ ومركبات جوية بدون طيار للجيش الروسي. وتضرب هذه العقوبات جوهر آلة بوتين الحربية، بحسب البيان.
كذلك استهدفت العقوبات معدات استخراج النفط والغاز التي تدعم قدرة التكرير الروسية. وستحد هذه الإجراءات من قدرة روسيا على زيادة الإيرادات لدعم “عدوانها” العسكري والحفاظ عليه. وتعمل هذه الإجراءات أيضا على مواءمة ضوابط التصدير الأميركية في هذا المجال مع الضوابط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
ثروة بوتين
وفي السياق، تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن ثروة بوتين عقب إعلان الحكومات الغربية عزمها تجميد الأصول المملوكة للرئيس الروسي في إطار عقوباتها.
وقالت الصحيفة إنه لا يبدو أن الحكومات الغربية تعلم يقينا بوجود مجموعات اقتصادية كبرى يمكن ربطها ببوتين، مشيرة إلى أنه على الورق يبدو وكأن بوتين يمتلك القليل جداً، لكن التقديرات تشير إلى أن ثروته الخفية تزيد على 100 مليار دولار.
وأضافت أنه في الواقع لا يُعرف الكثير عما يمتلكه الرئيس الروسي وأين، ويبقى حجم ثروته برغم سنوات من التكهنات والشائعات غامضاً بشكل محبط حتى مع تدفق مليارات الدولارات من خلال حسابات لأصدقاء مقربين منه وربط عقارات فاخرة بأفراد من أسرته.
ووفقا لبيانات مالية عامة فإن بوتين يكسب رسميا حوالي 140 ألف دولار سنوياً، ويمتلك فقط شقة صغيرة، لكن هذا لا يأخذ في الحسبان “قصر بوتين”، وهو ملكية شاسعة على البحر الأسود تقدر تكلفتها بأكثر من مليار دولار وذات تاريخ ملكية بيزنطي لا دخل له بالرئيس الروسي، لكن تم ربطه بحكومته بطرق مختلفة.
كما لا تأخذ هذه التصريحات المالية بعين الاعتبار “يخت بوتين” المسمى “الرشيق”، وهو مركب فاخر بقيمة 100 مليون دولار مرتبط به منذ فترة طويلة وفق تكهنات بعض التقارير الإخبارية، وقد تم تعقبه وهو يغادر ألمانيا متوجها إلى روسيا قبل أسابيع قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
#Putin´s Yacht “The Gracefull” inbound Kaliningrad from Hamburg in anticipation of future sanctions due to the conflict in #Ukraine. pic.twitter.com/qdhAUhCH1m
— Manu Gómez (@GDarkconrad) February 9, 2022
هناك أيضا شقة بقيمة 4.1 ملايين دولار في موناكو اشترتها امرأة يقال إنها عشيقة الرئيس الروسي عبر شركة خارجية، كما أن هناك فيلا باهظة الثمن في جنوب فرنسا مرتبطة بزوجته السابقة. وتؤكد الصحيفة أن مشكلة الولايات المتحدة وحلفائها في تفعيل عقوباتها المالية ضد بوتين تكمن في أنه لا يمكن ربط أي من هذه الأصول بشكل مباشر بالرئيس الروسي.
————————————
أوروبا تنجو من كارثة نووية..بعد قصف روسيا لمحطة زابوروجيا
عاشت أوروبا ليلة عصيبة بعد أن وردت تقارير تفيد باندلاع حريق قرب أكبر المفاعلات النووية في القارة في محطة زابوروجيا الأوكرانية، بسبب وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية بالقرب منها، ما أثار قلق كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين خرج قادتهما للتحذير من خطورة الأمر وعواقبه الوخيمة.
وأعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة، أن فرق الإطفاء تمكّنت في نهاية المطاف من إخماد النيران بعد دخول محطة زابوروجيا النووية التي اندلع فيها حريق نتيجة قصف روسي استهدفها، مطمئنة إلى أنّ السلامة النووية لهذا الموقع باتت “مضمونة”.
Запорізька АЕС pic.twitter.com/xDBOpYqWm1
— Промисловий Портал (@ua_industrial) March 4, 2022
وقال جهاز الحالات الطارئة التابع للحكومة في بيان على “فيسبوك”، إن “الوحدات تدخّلت لإخماد الحريق في مبنى التدريب”، مشيراً إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية وإن 40 إطفائياً و10 عربات إطفاء شاركوا في جهود إخماد النيران في المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا في منطقة إنرهودار على ضفاف نهر دنيبر.
وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا أولكسندر ستاروخ إن “مدير المحطة أشار إلى أن السلامة النووية باتت مضمونة. وبحسب المسؤولين عن المحطة، فإن مبنى للتدريب ومختبراً تضرّرا من جرّاء الحريق”.
وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد تحدثت عن إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية، خلال هجوم لقوات روسية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقالت الوزارة إن “رجال الإطفاء غير قادرين على بدء إخماد الحريق في المحطة، ويتعرضون لإطلاق نار من مسافة قريبة. وقد أصيبت أول وحدة للطاقة بالفعل”.
رعب نووي
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن موسكو تسعى لتكرار كارثة تشرنوبيل بقصفها محطة زابوروجيا النووية. وأضاف أن روسيا لجأت إلى الرعب النووي بقصفها المحطة. وطالب بوقف الجيش الروسي فوراً، مضيفا “إذا حدث أي انفجار نووي فستكون نهاية أوروبا”.
من جانبها، قالت مفتشية الرقابة النووية في أوكرانيا إن حجرة المفاعل بمحطة زابوروجيا النووية تعرضت لأضرار دون أن تؤثر على سلامتها. كما أفادت لاحقاً أن وحدة الطاقة الثالثة في المحطة تم فصلها في الساعة 2.26 صباحاً، ولم يتبقَّ سوى واحدة من الوحدات الست بالمحطة، وهي الوحدة الرابعة، قيد العمل.
ومنذ ساعات الصباح قالت السلطات المحلية إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
كما قال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا إن الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على محطة زابوروجيا النووية، واندلع حريق فيها الآن. وأضاف “إذا انفجرت المحطة سنكون أمام كارثة أكبر بعشر مرات من تشيرنوبيل”.
وطالب الوزير بوقف إطلاق النار في محيط المحطة فوراً والسماح بوصول رجال الإطفاء وإنشاء منطقة آمنة حولها.
الرد الروسي
ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن منشأة زاباروجيا النووية تحت سيطرتها وتعمل بشكل طبيعي. وأضافت أن قوات الحرس الوطني الروسي تصدت ل”مجموعة تخريبية” في منطقة مفاعل زابوروجيا، كما حمّلت أوكرانيا مسؤولية الحريق الذي نشب قرب المحطة النووية.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف من الاستفزاز في منشأة نووية هو محاولة لاتهام روسيا في خلق بؤرة تلوث نووي.
وأضافت أن قوات الحرس الوطني الأوكراني غادرت محطة زابوروجيا قبل وصول القوات الروسية. وقالت إن قوات الدفاع الروسية تسيطر على منشأة زابوريجيا منذ 28 شباط/فبراير.
موقع المحطة ودورها
يقع المفاعل النووي في جنوب شرق أوكرانيا في منطقة Enerhodar على ضفاف نهر دنيبر، حيث يبعد حوالي 200 كيلومتر عن منطقة دونباس المتنازع عليها و550 كيلومتراً جنوب شرق كييف.
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنتج مفاعلاتها الستة ما مجموعه 6000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. وبالمقارنة، كان مفاعل تشيرنوبيل في شمال أوكرانيا ينتج 3800 ميغاوات، عندما انفجر، أي أقل بمقدار الثلث تقريباً.
يذكر أن محطة زابوروجيا بُنِيت عام 1985 حين كانت أوكرانيا لا تزال جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق، وتضم ستة مفاعلات نووية وتوفر جزءاً كبيراً من احتياجات أوكرانيا من الكهرباء.
والآن تعود ملكية وإدارة المحطة الى شركة توليد الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية، وهي واحدة من أربع محطات نووية عاملة في البلاد، وتولد ما يصل إلى 42 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وخُمس إنتاج الكهرباء السنوي.
————————————
عقوبات غربية لن تردع/ نبراس إبراهيم
بعد أن اعترفت روسيا بجمهوريتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، ومن ثم غزوها لأوكرانيا في حرب تخترق وتتجاوز كل القوانين الدولية، ودخول حشود من الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية، وقصف هذا الجيش لمناطق سكنية وبنى تحتية دون رحمة – كما فعل في سوريا سابقاً – رأى الحلفاء الغربيون في حلف الناتو، أن أفضل وسيلة للضغط على الروس ورد هجماتهم هي فرض عقوبات على روسيا، غالبها سيكون له طابع اقتصادي، واعتقدت أن هذه الخطوة التي يمكن أن تتوسع يوماً وراء يوم في الغالب، وستكون رادعاً لروسيا لوقف حربها وسحب جيشها إلى قواعده من جديد، وتخلي القيصر الروسي عن هدفه وحربه المجنونة.
بدأ الحلفاء الغربيون بأول خطوة تحمل طابع العقوبات فأوقفت ألمانيا عملية التصديق على خط أنابيب “نورد ستريم 2″، الذي ينقل غاز روسيا إلى ألمانيا وأوربا، ثم أتبعها التحالف الغربي باستبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” الدولي للدفع، وقررت الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي وألمانيا عزل هذه المؤسسات عن التدفقات المالية الدولية، ثم منعت هذه الدول وغيرها الطائرات الروسية الحربية والمدنية من استخدام أجوائها، وقررت وقف الرحلات المتجّهة إلى روسيا، كما أكّد مسؤولون أوروبيون أن هناك حزمة من العقوبات يجهزها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستصدر تباعاً.
على الرغم من أن بعض الدول قررت تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، كهولندا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها، إلا أن هذه المساعدات جاءت متأخرة قليلاً من جهة، وخجولة لا تتناسب مع ما يحشده الوحش الروسي لغزو أوكرانيا من جهة أخرى، ولا يمكن لهذه المساعدات البسيطة أن تقلب معادلة القوة وحدها، وإنما يمكن أن تساهم فقط في كسب الوقت وتأخير هزيمة الأوكرانيين العسكرية، باعتبار أن عدد وعتاد الجيش الروسي يفوق بأضعاف مضاعفة عدد وعتاد الجيش الأوكراني، خاصة وأن روسيا لن تتردد في استخدام كل مخزون السلاح الذي لديها، بما فيه أسلحة التدمير الشامل، لتحقيق هدفها، حتى لو تركت أوكرانيا أرضاً محروقة عن بكرة أبيها.
في الغالب الأعم لن ينجح سلاح العقوبات مع روسيا، فالتفكير الروسي سيتعطل أمام آلة الحرب والعنف، وستزيد هذه العقوبات من تعنّت وإصرار روسيا على المضي بخطتها حتى لو كلفها ذلك تجويع الشعب الروسي كلّه، أو مقتل نصف جنود الجيش الروسي، فالقيصر لا يرى سوى ذاته وسيحاول بكل الوسائل التمسك بقراره ليثبت للعالم أنه على صواب وأنه قادر أن يغير موازين العالم وقادر أن يواجه القوى الكبرى.
من جهة ثانية، لا بد من ملاحظة أن الرئيس الروسي عمل منذ عام 2015 على إنشاء أنظمة معالجة مدفوعات خاصة بروسيا، كبديل لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “ما يعرف باسم سويفت” لأنه كان قد هُدِّدَ سابقاً بطرد روسيا منه، وقامت موسكو بإطلاق منصة الدفع “مير” بعد أن بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا خلال السنوات العشر الأخيرة.
ومن جهة ثالثة، لا بد من ملاحظة أن روسيا تمتلك احتياطياً كبيراً من النقد، وراكمت في بنوكها نحو 700 مليار دولار نقداً، كما راكمت رصيداً من الذهب تبلغ قيمته 130 مليار دولار، وتشير بعض الأرقام إلى وجود أكثر من 5 آلاف طن من الذهب المتراكم في البنوك الروسية رغم كل العقوبات التي فُرضت على روسيا خلال العقد الأخير من قبل أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي يؤكد بدوره على أن العقوبات الاقتصادية لن يكون لها ذلك التأثير الرادع على روسيا ونظامها.
لن يهتم النظام الروسي إن كلّفت الحرب والعقوبات روسيا مئة أو مئتي مليار، فهو سيواصل عنجهيته وجنونه بغض النظر عن الكلفة المادية والاقتصادية، ولن يهتم إن انخفض مستوى الدخل للشعب الروسي، أو تراجع سعر الروبل، أو شحّت المواد الأولية، أو سقطت شرائح جديدة من الروس في مستنقعات الفقر والجوع، ولن يأبه إن توقفت معامل أو أغلقت ورشات، فما يهمه أساساً استمرار المُلك وفرض السلطة الديكتاتورية والمكانة الحربية العالمية.
لم تكن ناجعة تلك العقوبات التدريجية التي فُرضت من قبل الغرب ضد روسيا، كما لم تكن ناجعة العقوبات التي فُرضت على النظام السوري خلال أكثر من عقد ونصف بسبب حربه المُدمّرة المقيتة ضد شعبه، كما لم تُفلح العقوبات التي فُرضت على إيران خلال أكثر من عقدين بسبب برنامجها النووي وأعمالها الإرهابية حول العالم، ولم تُفلح عقوبات سابقة فُرضت على العراق بسبب حرب الخليج، وعقوبات فُرضت على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وتجاربها الصاروخية وإرهابها الدولي، وعقوبات فُرضت على كوبا بسبب تحالفها مع الاتحاد السوفييتي ودعمها لأنظمة تمييزية، وعقوبات فُرضت على بورما بسبب التطهير العرقي الإرهابي الذي قامت به، وعقوبات فُرضت على جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري “الأبارتيد” وغيرها من العقوبات التي فُرضت على دول أخرى.
من الواضح أنه لن تصلح العقوبات الاقتصادية مع الروس، فهم قادرون على تجاوز تأثيراتها، أو على الأقل تأجيلها، كما أنهم لا يأبهون أساساً بنتائج تلك العقوبات التي ستطول الشعب والدولة، وبالتالي لابد للحلفاء الغربيين إن أرادوا أن يوجعوا روسيا ويجبروا الرئيس الروسي على وقف حروبه، التي طالت خلال عقد أكثر من بلد من بينها سوريا وآخرها أوكرانيا، أن يفكروا بعقوبات أقصى، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل عقوبات مبتكرة أقسى، منها على سبيل المثال لا الحصر، مساعدة المقاومة الشعبية الأوكرانية بقوّة وجدّية، وتفعيل المحاكم الدولية التي يمكن لها أن تُحاكم بوتين وزبانيته وكل مجرمي الحرب الروس، وتحجيم التصدير والاستيراد من وإلى روسيا إلى أقصى حد ممكن، وسحب الاستثمارات الغربية من روسيا، ووقف المشاريع المشتركة، ومعاقبة من يتعامل تكنولوجياً مع روسيا، والضغط لإعادة تفعيل مسار الحل السياسي في سوريا، وعدم الترحيب بروسيا في المؤتمرات الدولية من أجل تحقيق عزل شامل وكامل لروسيا، لتبقى روسيا شبه وحيدة ومعزولة عن العالم.
ومن الصعب وغير المنطقي ولا المعقول أن يُصعّد الحلفاء الغربيون مع روسيا عسكرياً، لأن نهاية مثل هذا التصعيد خطيرة وكارثية، لكن من الضروري التصعيد في كل شيء آخر، وعزل هذا الديكتاتور الذي جعل دولته في أعين البشرية دولة مارقة شريرة مجرمة، وخاض حروباً وقتل بشراً، ودون هذا التصعيد في الغالب الأعم لن يستمر في غيّه وحسب، بل سيُفسح له المجال لتكرار ما يحصل في دول أخرى، وتنفيذ مخططات أكبر.
تلفزيون سوريا
——————————-
“الغزو الروسي لأوكرانيا.. السيناريوهات والانعكاسات” في ندوة لحرمون
أنظّم مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يوم الإثنين 28 شباط/ فبراير 2022، ندوة حوارية بعنوان: “الغزو الروسي لأوكرانيا.. السيناريوهات والانعكاسات“، شارك فيها الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأدارها عمر إدلبي، مدير مكتب الدوحة في مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
—————————
الحرب العالمية الثالثة قد بدأت.. كيف ستسير؟/ كمال اللبواني
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا نكون قد دخلنا مباشرة في الحرب العالمية الثالثة، حيث تحدث مواجهة عالمية ساخنة بين معسكرين متناقضين انتقلا من التنافس للصراع، حيث لم يعد ممكناً لتعايشهما معاً، لا بد أن يقضي أحدهما على الثاني أو يستنزف أحدهما الآخر ليظهر لاعب جديد.
لم يكن خيار الحرب خياراً غربياً، بل روسياً صينياً، بعد أن شعروا بتنامي القوة الذاتية من جهة، وبضعف وعجز الغرب، الذي دخل في أزمة اقتصادية عميقة مستمرة منذ بداية هذا القرن تعمقت كثيراً بعد كورونا. قررت روسيا استثمار حالة الضعف باستعادة أمجادها وسيطرتها على دول الجوار، فهددت أوكرانيا آملة في إخضاعها بالتهديد والوعيد.
قرر الغرب عدم الاستجابة للضغوط، ودفع روسيا للتدخل العسكري الذي سيدفعون ثمنه اقتصادياً، قامت الصين بتقديم دعم اقتصادي ثابت للروس يجعلها قادرة على تحمل العقوبات، وقد شجع عدم استعداد الغرب للدفاع العسكري عن أوكرانيا، فدفعت روسيا جنودها عبر الحدود، متوقعة عدم حصول مقاومة عسكرية فعالة، وفرض الغرب حزمة عقوبات متوسطة الشدة، ولم تقرر السلطات الأوكرانية التصدّي العسكري للغزو، كونها معركة خاسرة، وهكذا سارت الأيام الثلاثة الأولى من الغزو.
في اليوم الرابع تغير المزاج العام للشعب الأوكراني، الذي لا يأبه بالحسابات العسكرية بل يهتم بالمعاني والقيم، قامت مجموعات بالتصدي العسكري للهجوم، “لن نسمح للغزو أن يدخل من دون دماء”، إنه قرار الكرامة الذي ستدفع أوكرانيا ثمنه باهظاً قرباناً للحرية والحضارة. وهنا رفعت العقوبات الغربية لأقصى درجاتها، ودخلنا مباشرة للمرحلة الساخنة من الحرب التي ستكون ساخنة وطويلة على الأرض الأوكرانية وعلى أرض سوريا وساحات الصراع الأخرى.
أصبح العالم في سباق مع الزمن لإسقاط بوتين ونظامه، وهنا ستشتد المعارك في كل مكان من دون التدهور لحرب مباشرة، فإذا سقط بوتين وانضمت روسيا للغرب، تحاصرت الصين وانكفأت، وإذا صمد بوتين وسحق أوكرانيا فستكون مواجهات قاسية في طول العالم وعرضه وفي كل الأصعدة تنتهي بعزلة الغرب، وحصاره، أو بسقوط النظم المستبدة المافيوية في الصين وروسيا.
هنا سيحسم المواجهة في العالم الثالث، وبشكل خاص العالم الإسلامي، الذي سيشكل انضمامه لأحد الطرفين بيضة القبان، فإذا تعاونت النظم المستبدة السائدة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه مع روسيا والصين، سقط الغرب، وإذا استطاعت الشعوب التعبير عن نفسها وتحقيق الإصلاحات الديمقراطية ستجد نفسها في قلب المعركة مع الحضارة الغربية بطابعها الديمقراطي.
المعركة إذن هي معركة مبادئ حقوق الإنسان والحريات والنظم الديمقراطية مع النمط الشمولي المافيوي الفاسد من الرأسمالية، وهنا وبهذا الشعار يصبح الشعب الروسي والصيني في خندق المواجهة مع نظمه، وهذا كفيل بحسم الصراع على المدى البعيد، هذا يتوقف على طريقة إدارة الغرب للمعركة ومقدار إخلاصه لمبادئه وحلفائه الذين يجب أن يكونوا داعماً لكل الشعوب الطامحة للحرية والكرامة وليس نظم الفساد والاستبداد، التي قامت بدعم من الغرب لتنقل ولائها للشرق الذي يشبهها بفعل الحرب العالمية القائمة بين الخير والشر.
ليفانت – كمال اللبواني
—————————
الأخطاء القاتلة في حسابات بوتين/ كمال اللبواني
بوتين في قصره القيصري يعيش في التاريخ والأحلام أكثر منه في الواقع، وبشكل خاص أمجاد روسيا القيصرية والسوفيتية، وبنى حساباته على ظروف الحرب العالمية الثانية، وتوقع أن يجد في أوكرانيا ترحيباً واسعاً بالنفوذ الروسي.
واتهم معارضيه في أوكرانيا بالنازيين تذكيراً لهم بالمعركة الحاسمة للحرب العالمية الثانية في أوكرانيا (ستالين غراد)، حيث لم يتوقع أن يقف الأوكرانيون إلى جانب الغرب النازي الذي غزاهم وقاتلوه مع الروس وهزموه، فانضمام أوكرانيا للناتو لا يعني بالنسبة له سوى انتصار النازيين الجدد، وبذات الوقت راهن على حياد ألمانيا التي افترض أنها لم تنسَ خسارتها المريرة في كييف، حيث تم القضاء التام على نصف مليون جندي ألماني هناك.
لذلك فوجئ الجميع بالمقاومة الشعبية التي انطلقت في أوكرانيا بعد تخاذل القيادات العسكرية، والتي أيضاً دفعت بالغرب لاستغلال الفرصة التاريخية لقتال الجيش الروسي على الأرض الأوكرانية وكسر طموحات روسيا التوسعية وإلى الأبد، حيث بدأت فعلاً بإرسال جنودها وعتادها لقتال الروس تحت العلم الأوكراني، مع تطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية غير مسبوقة في العالم، وما فاجأه أكثر هو تحول موقف ألمانيا من التردد للانخراط الكامل وتوحد أوروبا كلها، بما فيها بريطانيا، العدو الشرس لروسيا ومن ورائها أمريكا، وتشكيلهم حلفاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، أظهر الكثير من التماسك والجدية، فاجأت روسيا والصين أيضاً.
تفاجأ بوتين أيضاً في دولته وشعبه وجيشه، فقد راهن على إرادة القتال والنزعة القومية عند الروس وتجاهل كأي ديكتاتور فاسد أنه حول روسيا لمزرعة فساد وعصابات خاصة به وحاشيته، أصبح الجميع يكرهها ويتمنى هزيمتها، وضلله قمعه عن رؤية التعاطف الكبير بين الشعب الروسي وأوروبا الحرة الديمقراطية، وبشكل خاص عند الجنود الروس الذين يشعرون أنهم يقتلون أخوتهم من دون مبرر غير نزعات ديكتاتور أذاقهم مرارة الذل والهوان وقتل واعتقل وأفقر عموم الشعب.
كما ضلله قمعه وديكتاتوريته عن إدراك مدى هزالة جيشه ونخر الفساد فيه، فالجيش الروسي تعود إرسال تقارير الجاهزية التي تريدها القيادة، والتعمية على منظومة فساد نخرت عميقاً بنيته، وقدراته، وإمكاناته، حيث تحول الضباط إلى أوليغارشية وعصابات فساد وتشبيح، وأصبح هم كل جندي هو زيادة دخله بكل الوسائل، وهذا ما يجعله غير قادر على خوض أي حرب ذات شعارات يجب أن يموت من أجلها في حين هي تخدم مصالح فردية لآخرين، وهذا ما يفسر بطء التقدم الروسي وعجزه عن إنجاز أي حسم عسكري، خاصة عندما وصل للمدن التي تقاوم بشدة والمكتظة بالمدنيين، حيث يشعر الجندي الروسي بهول المعركة وهول الكارثة الإنسانية التي يتسبب بها ديكتاتور فاسد وأناني ومختل يهدد بالنووي.
هذه الأخطاء كافية لهزيمة بوتين، وقلب نظام حكمه كنتيجة لخسارته الحرب، خاصة عندما يستمر في سياسة القمع لكل انتقاد وتحميل مسؤولية الفشل لكل من يحيطون به، مما سيوحدهم ضده لينقلبوا عليه.
—————————–
======================
تحديث 05 أذار 2022
————————-
عن ستالينية بوتين وما يُخفيه تلميحه عن «اغتصاب» أوكرانيا/ سلافوي جيجيك
الترجمة عن الألمانية: سولارا شيحا
علّقَ فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي، في السابع من شباط/فبراير 2022، على عدم رضى الحكومة الأوكرانية عن اتفاقية مينسك بالقول: «سواء أعجبكِ أم لا، إنه واجبكِ يا جميلتي» لهذا التعلّيق دلالات جنسية معروفة: يبدو أن بوتين يُشير إلى مقطع من أغنية «الجميلة النائمة في تابوت» لفرقة البانك روك السوفييتية «العفن الأحمر» Красная Плесень: «الجميلة النائمة في التابوت، تسللت إليها وضاجعتها. سواء أعجبكِ أم لم يُعجبكِ، نامي يا جميلتي».
وعلى الرغم من أن ممثل الكرملين الإعلامي زَعمَ أن التعبير ليس سوى مَثَل فولكلوري قديم، تبقى الإشارة واضحة إلى أوكرانيا، بوصفها موضوعاً لرغبة الاغتصاب ومُجامعة الموتى. وفي معرض ردّه مرّةً على سؤال صحافي غربي، في مؤتمر عُقد عام 2002، قال بوتين: «إن كنتَ تُريد أن تُصبح إسلامياً متطرّفاً، وكنت مستعدّاً للخضوع للختان، فأنا أدعوك إلى موسكو. نحن بلدٌ متعددة المذاهب، ولدينا أخصائيون في هذه المسألة (الختان) سأوصي بتنفيذ العملية، بحيث لا يُمكن لشيء أن ينمو بعدها». تهديد سوقي حقاً بالإخصاء.
وقفة البلطجي:
لا عجب في أن بوتين وترامب كانا رفيقين في السوقية والبذاءة. وكثيراً ما سمعنا الحجة المدافعة عن سلوكهما، والتي ترى أن السياسيين أمثالهما يتحدّثان بصراحة دون نفاق. هُنا يُمكنني القول، إني من صميم قلبي أقف في صفِّ النفاق! إذ أن الشكل (المتمثّل بالنفاق في هذه الحالة) ليس أبداً مجرّد شكل، وإنما هو جزء من المضمون، وعندما يَسقُط الشكل، يتشوّه معه المضمون بشدّة. تجب قراءة تعليق بوتين السّوقي على خلفية الأزمة الأوكرانية، التي يُشار لها في وسائل الإعلام لدينا على أنها تهديدٌ بـ»اغتصاب بلدٍ مسالم». لا تخلو هذه الأزمة من جوانبٍ كوميدية، الأمر الذي إن دلّ على شيء في عالمنا المقلوب، فهو يدل على مدى خطورتها. وقد أشارَ المحلل السياسي السلوفيني بوريس شيبيتج، مطلعَ العام الحالي، إلى الطابع الكوميدي للتوتّر المحيط بأوكرانيا: «ينفي المهاجِمون المُتوَقَّعون (أي روسيا) أيّ نيّة لديهم بالهجوم، ويصرُّ أولئك الذين يريدون تهدئة الوضع على أن الهجوم أمرٌ مؤكد الوقوع».
سلافوي جيجيك
في الأسابيع القليلة الماضية حذَّرت الولايات المتحدة الأمريكية (حامية أوكرانيا) من إمكانية اندلاع الحرب في أي لحظة، في حين حذَّر الرئيس الأوكراني (الضحية المُحتَملة) من الهيستيريا، ودعا إلى الهدوء والتأنّي. من السهل تشبيه الوضع بالاغتصاب: تدّعي روسيا، الجاهزة لاغتصاب أوكرانيا، أنها لن تفعل، لكنّها بين السطور تهددُ بذلك، في حال رفضِ الأخيرة الجنس (فلنتذكر تعليق بوتين المبتذل) وفي الوقت ذاته تتهمُ روسيا أوكرانيا باستفزازها وإثارتها لتقوم باغتصابها. فيما تدق الولايات المتحدة، التي تريد حماية أوكرانيا، ناقوس الخطر، محذِّرةً من الاغتصاب الوشيك، حتى تتمكن من فرض نفسها مدافعة عن الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق. يُذكّرنا موقفها هذا ببلطجي يعرِضُ الحماية للمتاجر والمطاعم في منطقته ضد السرقة أو التخريب، مع تهديد مستتر بالأذى في حال رفضها. تحاول أوكرانيا المستهدفة بالتهديدات التزام الهدوء، تُقلِقها أيضاً أجراس الإنذار الأمريكية، مدركة أن الاهتياج والجلبة حول الاغتصاب المُفتَرَض قد يدفعان روسيا بالفعل لاقترافه.
عجزُ المُعتدي:
إذن ما الذي يَكمُن وراء هذا الصراع، في كل أخطاره التي لا يُمكن التنبؤ بها؟ ماذا لو أن خطورة الصراع ليست مؤشراً على النفوذ المتزايد للقوتين العُظميين السابقتين، وإنما على العكس، هي دليل على إنكارهما العنيد حقيقةَ أنهما لم تعودا قوى عالمية حقيقية. شَبّهَ ماو تسي تونغ، في ذروة الحرب الباردة، الولاياتَ المتحدة الأمريكية بكل أسلحتها وعتادها بنمرٍ من ورق، إلا أنه نسي أن يُضيف أن النمور الورقية قد تكون أكثر خطورة من تلك الحقيقية الواثقة من جبروتها.
لم يكن الفشل الذريع في الانسحاب من أفغانستان إلا أحدث لطمة في سلسلة لطمات تلقّاها تفوّق السيادة الأمريكية. وليست جهود روسيا لإعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية سوى محاولة يائسة للتغطية على واقع ضعفها واضمحلالها. وكما الحال مع المُغتَصِبين الحقيقيين، يكون الاغتصاب دليل عجز المُعتدي. العجز الروسي جليٌّ الآن بعد بدء الاغتصاب، من خلال أول اختراق مباشر للجيش الروسي لأوكرانيا، هذا إن لم نُدخِل في الحسبان الدور القذر لمجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الخاصة، التي شارك مقاولوها في نزاعات متعددة، منها الحرب الأهلية السورية، وشبه جزيرة القرم ووسط افريقيا وجمهورية صرب البوسنة. مجموعة جنود المرتزقة المجهولين هذه، التي تشكل ذراعاً طويلة لوزارة الدفاع الروسية، عندما يكون نفي المسؤولية ضرورياً، تعمل منذ سنوات في حوض دونباس، تنظِّم فيه المقاومة العفوية ضد أوكرانيا (كما فعلَتْ سابقاً في جزيرة القرم).
مبادئ ستالين:
الآن وبعد تفجّر الوضع، ناشد مجلس الدوما الروسي بوتين مباشرةً للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، الخاضعتين للنفوذ الروسي. ردُّ بوتين الأوّلي كان رفض الاعتراف باستقلالية الجمهوريتين سابقتي الذكر، ليبدو الأمر وكأن اعترافه اللاحق باستقلاليتهما ليس إلا استجابةً للضغط الشعبي، أي استجابةً لضغطٍ من الأسفل، وهو بذلك يتَّبِعُ النهج الذي نصّه ستالين ومارسه لعقود. في منتصف عشرينيات القرن الماضي، اقترح ستالين اتخاذ قرار يُعلِنُ ببساطة حكومةَ جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية حكومةً للجمهوريات الخمس الأخرى أيضاً (أوكرانيا، بيلاروسيا، أذربيجان، أرمينيا وجورجيا). «في حال تمّت الموافقة على القرار من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، فلن يُعلَن أو يُنشَر، بل ستتم إحالته إلى اللجان المركزية للجمهوريات، لإحالته من قبلهم إلى أجهزة مجلس السوفييت الأعلى، أو إلى اللجنة التنفيذية المركزية، أو إلى مؤتمرات السوفييتات في الجمهوريات المذكورة، قبل انعقاد المؤتمر السوفييتي لعموم روسيا، الذي ستتم فيه الموافقة على القرار، بناءً على رغبة وطلب تلك الجمهوريات» أي أنه لم يتم إلغاء التفاعل بين السلطة العليا (اللجنة المركزية) وقاعدتها وحسب، بحيث تَفرِضُ السلطة العليا إرادتها ببساطة، بل لجعل الوضع أسوأ، تمَّ ترتيبه لإظهاره على نقيض حقيقته: تُقرِّرُ اللجنة المركزية مطالبَ قواعدها منها، وكأنها فعلاً رغبتهم. لنتذكر الترتيب الأبرز من هذا النوع: في عام 1939، عندما طَلَبت دولُ البلطيق الثلاث الانضمام إلى الاتحاد السوفييتي طواعيةً، ووافق الأخير على رغبتها. ما قام به ستالين في أوائل الثلاثينات كان مجرّد رجعة إلى السياسات الداخلية والخارجية للحكم القيصري السابق للثورة، وهكذا، على سبيل المثال، لم يعد الاستعمار الروسي لسيبيريا وآسيا المسلمة مُداناً باعتباره توسُّعاً إمبريالياً، وإنما محتفىً به، باعتباره فاتحة للتحديث التقدّمي.
عقدَ بوتين، بطريقةٍ مشابهة، مجلسَ الأمن الخاص به، سأل فيه كبار المسؤولين إن كانوا مؤيدين لقرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. عندما حان دور رئيس الاستخبارات سيرجي ناريشكين، ويمكن مشاهدة المقطع على يوتيوب، اقترحَ في البداية إعطاء الغرب فرصة أخيرة لاحترام اتفاقيات مينسك، عبر توجيه إنذارٍ أخير له.
قاطعه بوتين بجفاف: «ماذا تقصد؟ هل تريد بدء مفاوضات أم الاعتراف بالاستقلال؟». بدأ عندها ناريشكين بالتلعثم، دون أن يعرف ما يجب قوله، تمتَمَ بعدها: «نعم» ثم «لا» وشَحبَ وجههُ لثوانٍ، بدت وكأنها دامت دهراً. يتدخل بوتين: «تكلّم بوضوح». يقوم رئيس الاستخبارات، شاعراً بالضغط، بعكس المسار، ويذهب خطوة أبعد، مصرحاً بدعم قرار ضم دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا الاتحادية! يقاطعه بوتين مرة أخرى: «نحن لا نتحدث عن ذلك. نحن نناقش الاعتراف باستقلالهما». يتراجع ناريشكين القلق عن تصريحه، ويدعم الاعتراف بالاستقلال، وعندها يشكرهُ بوتين: «شكراً، يمكنك الجلوس مجدداً».
على الرغم من مناشدة الحزب الشيوعي الروسي، في كانون الثاني/يناير 2022، بوتين بالاعتراف بالمنطقتين (الأمر الذي رفضَه الأخير، مُمَثِّلاً دور رجل قانون صبور) من المهم جداً أن ننتبه إلى أن الغزو الجاري للدونباس يُشكِّلُ الرفض الأخير والقاطع للإرث اللينيني في روسيا. المرّة الأخيرة التي احتلَّ فيها لينين عناوين الصُّحُف الغربية كانت أثناء الانتفاضة الأوكرانية عام 2014، التي أطاحت بالرئيس يانوكوفيتش الموالي لروسيا. شاهدنا على شاشات التلفزيون أمواج المتظاهرين الغاضبين في كييف يُسقطون تماثيل لينين. يسهل فهم دوافع هذه الهجمات الغاضبة، في حال قُرِأت تماثيل لينين بوصفها رمزاً للقمع السوفييتي، وروسيا بوتين على أنها استمرار للسياسة السوفييتية، التي أخضَعت تحت حكمها الدول غير الروسية.
المُذنب هو لينين:
إلا أنها لمفارقة كبيرة فعلاً أن الأوكرانيين، تعبيراً عن رغبتهم بتحقيق سيادتهم الوطنية، أسقطوا تماثيل لينين، فالعصر الذهبي للهوية الوطنية الأوكرانية لم يكن روسيا القيصرية (وقتها تم إحباط الإرادة الذاتية للأمة الأوكرانية) وإنما كان أثناء العقد الأول للاتحاد السوفييتي، حين أسس الأوكرانيون هويةً وطنية كاملةً، بعد اتباع الاتحاد سياسة «التوطين/التجذير» (Korenisazija)التي أرادت تجنّب نفورَ الشعوبِ غير الروسية في الاتحاد السوفييتي من المُثُل الشيوعية». وصاغ لينين مبادئ سياسة التوطين مطلع عام 1916 بشكلٍ لا لبس فيه: «لا يَسَعُ البروليتاريا إلا أن تكافح ضد الاستبقاء القسري للأمم المضطهَدة ضمن حدود دولة معيّنة، وهذا بالضبط ما يعنيه النضال في سبيل حق تقرير المصير. على البروليتاريا المطالبة بحق الانفصال السياسي للمستعمرات والشُّعوب الواقعة تحت اضطهاد دولتها نفسها. إن لم تقم بذلك، ستبقى الأممية البروليتارية شعاراً فارغاً، إذ سيكون من المستحيل بناء ثقة متبادلة وتضامن طبقي بين عُمَّال الأمم المُضطهِدة والمُضطهَدة». بقي لينين مُخلصاً لهذا الموقف حتى النهاية: في نضاله الأخير ضد مشروع ستالين الهادف لإقامة اتحاد سوفييتي مركزي، دافعَ مرَّةً أخرى عن الحق غير المشروط للدول الصغيرة في الانفصال (جورجيا في هذه الحالة) وأصرَّ على السيادة الكاملة للكيانات الوطنية، التي شكَّلت بمجموعها الدولة السوفييتية. فلا عجب أن قام ستالين باتهام لينين علانيةً بـ»الليبرالية القومية» في رسالةٍ إلى أعضاء المكتب السياسي في 27 أيلول/سبتمبر عام 1922.
سياسة بوتين الخارجية هي استمرارٌ واضح لهذا الخط القيصري ـ الستاليني، فوفقاً لبوتين، جاء دور البلاشفة، بعد الثورة الروسية عام 1917، لمضايقة روسيا: «من الصواب الاسترشاد بأفكاركَ عندما تحكم، لكن فقط في حال أتت أفكارك بالنتائج الصحيحة. ولم تكن الحال كذلك مع فلاديمير أليتش. أدت فكرته هذه في النهاية لانهيار الاتحاد السوفييتي. كانت هنالك أفكار كثيرة من هذا النوع، من قبيل منح مناطق الحكم الذاتي وما شابه، وكانت بمثابة قنبلة ذرية، تم زرعها أسفل البناء المسمّى روسيا، وانفجرت لاحقاً».
«ما العمل؟»:
أي باختصار، لينين هو المُلام، فقد أخذَ على محمل الجد استقلالية الدول المختلفة، التي شكّلت الامبراطورية الروسية، وبالتّالي قوّضَ الهيمنة الروسية (حسب بوتين) لا عجب في أننا نرى صور ستالين من جديد في المسيرات العسكرية والاحتفالات العامة في روسيا اليوم، بينما يتم طمس لينين. في استطلاعٍ للرأي منذ بضع سنوات، تم اعتبار ستالين ثالثَ أعظم روسي في كل العصور، بينما لم نرَ أثراً للينين في اللائحة.
لا يتم الاحتفاء بستالين باعتباره شيوعياً، إنما باعتباره مُنعشَ عظمةِ روسيا بعد ضلال لينين غير الوطني. ولا عجب أيضاً في أن بوتين أثناء إعلانه التدخل العسكري في حوض دونباس في 20 فبراير2022، كرّرَ ادعاءه القديم بأن لينين، الذي اعتلى سدة الحكم بعد الإطاحة بعائلة القيصر رومانوف، هو مُنشئ ومُخترع أوكرانيا، مؤكداً: «دعونا نبدأ من حقيقة أن أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها بالكامل من قبل روسيا، ولنكن أكثر دقة، تم بناؤها على يد روسيا الشيوعية البلشفية، بعد ثورة 1917مباشرةً».
هل يُمكن لبوتين أن يكون أكثر وضوحاً؟! جميع اليسارين، الميالين لروسيا حتى الآن من منطلق أنها تبقى، على الرغم من كل شيء، خليفة الاتحاد السوفييتي، والديمقراطيات الغربية مزيفة، وأن بوتين يعارض الإمبريالية الأمريكية، إلخ، يجب أن يواجهوا الحقيقة المرّة بأن بوتين ليس سوى قومي مُحافِظ. وروسيا لن تعودَ لأيام الحرب الباردة القديمة، ذات القوانين الثابتة، إنما ما يحدث أكثر جنوناً بكثير: ليست حرباً باردة وإنما سلامٌ ساخن، سلامٌ يرقى إلى حربٍ مستمرّة هجينة (هيبريدية) يتم فيها إعلان التدخلات العسكرية على أنها مهامٌ إنسانية لحفظ السلام، ودرء خطر الإبادة الجماعية: «يُعرب مجلس الدوما عن دعمه الكامل والواثق للتدابير المناسبة المتخذة لأسباب إنسانية».
كي نختتم بسؤال لينين: «ما العمل الآن؟» علينا جميعاً، نحن في البلدان التي تُشاهد مأساة اغتصاب أوكرانيا، إدراك أن الإخصاء الحقيقي هو الرادع الوحيد للاغتصاب. لذا علينا حث المجتمع الدولي على القيام بعملية إخصاء لروسيا (وإلى درجة ما للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً) بتجاهلها وتهميشها قدر المستطاع، والحرص على تنفيذ عملية الإخصاء هذه، بحيث لا يمكنُ لنفوذ روسيا العالمي أن ينمو بعدها.
*سولارا شيحا : كاتبة ومترجمة سورية
المقال بالألمانية:
القدس العربي
—————————-
حسابات واشنطن في أوكرانيا ومحاولات احتواء روسيا
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
تماشيًا مع التوقعات الغربية، والأميركية تحديدًا، أطلقت روسيا، صباح يوم 24 شباط/ فبراير 2022، عملية عسكرية شاملة في أوكرانيا، حدّدت هدفها بنزع سلاح هذه الأخيرة، وإطاحة حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الساعي إلى ضمّ بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما ترفضه روسيا. جاء القرار الروسي بعد يومين فقط من إعلان موسكو اعترافها باستقلال إقليمَي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليَين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وردّت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي و”الناتو” وآخرون، بفرض جملة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على موسكو، شملت الرئيس فلاديمير بوتين، والدائرة الضيقة المحيطة به. وزادت الدول الغربية من حجم مساعداتها الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا بهدف رفع تكلفة الغزو على روسيا. وقد دفعت هذه الإجراءات الرئيس بوتين إلى التهديد المبطّن باللجوء إلى السلاح النووي، ما أجّج المخاوف من إمكانية اتساع المواجهة وتصاعدها جرّاء خطأ في حسابات أحد الطرفين.
سلاح العقوبات
في سياق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، كان لافتًا التزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتنفيذ التهديدات التي أطلقها خلال قمّة افتراضية جمعته بالرئيس بوتين، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، في محاولته ردع روسيا عن القيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا. وكان بايدن هدّد حينها بفرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ “مدمّرة” ضد روسيا، وتقديم دعم عسكري لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة هجومية متقدّمة، والسعي إلى عزل موسكو دوليًا، إذا هي أقدمت على غزو أوكرانيا. وكان واضحًا الجهد الذي بذلته واشنطن في التنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، واليابان وأستراليا، وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، لمعاقبة روسيا. وقد تمكّنت واشنطن من تجاوز مخاوف بعض شركائها الذين قد تتأثر مصالحهم بشدّة نتيجة فرض عقوبات معيّنة على روسيا، خصوصا ما يتعلق منها بمنع بنوك ومصارف روسية من الوصول إلى نظام SWIFT للتعاملات المصرفية والتحويلات المالية الدولية. كما استُثني قطاع الطاقة الروسي من العقوبات؛ مراعاةً لمصالح الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمد كثير منهم على النفط والغاز المستوردَين من روسيا، في ظل عدم توافر بدائل سريعة ومجدية اقتصاديًا، وأيضًا، وربما الأهم بالنسبة إلى إدارة بايدن، منعًا لحصول ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، المرتفعة أصلًا، وهو ما سيضرّ بمصالح الولايات المتحدة نفسها وبالمستهلك الأميركي الذي بات يدفع نحو 40% تكلفة إضافية للوقود مقارنةً بالعام الماضي، ما يؤثر في حظوظ الديمقراطيين في سنة انتخابية حاسمة. وتعدّ روسيا ثاني مصدّر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وأكبر مصدّر للغاز.
وقد اتبعت واشنطن وحلفاؤها أسلوبًا متدرّجا في فرض العقوبات، على أمل أن يمنع ذلك روسيا من اتخاذ إجراءات تصعيدية أكثر في حربها ضد أوكرانيا. وجاءت أول دفعةٍ من العقوبات مباشرة عقب اعتراف روسيا باستقلال إقليمَي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليَين. وشملت العقوبات الأميركية خط نقل الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، المعروف بـ “نورد ستريم 2″، وذلك بعد إعلان ألمانيا تعليق العمل به، وحظْر التعامل مع بنكيْن روسيَين، أحدهما عسكري. وتضمّنت، أيضًا، منعًا لتداول الديون السيادية الروسية في الأسواق الغربية، إضافةً إلى فرض عقوباتٍ على الأثرياء الروس المقرّبين من الكرملين وعلى أفراد عائلاتهم.
وبعد دخول القوات الروسية أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت إدارة بايدن بالتنسيق مع مجموعة السبع الكبار (G7)، إضافةً إلى أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، عن إجراءات للحدّ من قدرة روسيا على القيام بأيّ أعمال تجارية بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الين الياباني، في مسعى لتقييدها في النظام الاقتصادي العالمي. كما شملت العقوبات بنك “في تي بي” أكبر بنوك روسيا، الذي يمتلك وحده أكثر من ثلث الأصول المصرفية الروسية، إضافةً إلى أربعة بنوك كبرى أخرى، تمتلك مجتمعةً ما يوازي تريليون دولار أميركي. وتوسعت دائرة العقوبات لتشمل التكنولوجيا المتطوّرة، بما في ذلك أشباه الموصلات، وذلك بهدف الحدّ من إمكانيات روسيا في تطوير قدراتها العسكرية والمدنية، بما في ذلك صناعة الطيران، على نحوٍ يقلل كفاءتها على المنافسة عالميًا، ويسدّد “ضربة كبيرة لطموحات بوتين البعيدة المدى”. وفي اليوم التالي (25 شباط/ فبراير) أعلن البيت الأبيض انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوباتٍ تستهدف الرئيس الروسي ووزير خارجيته، سيرجي لافروف، وبهذا يكون بوتين أول رئيس لدولة كبرى يخضع لمثل هذه العقوبات، ولينضم بذلك إلى رئيسَي بيلاروسيا وسورية، ألكسندر لوكاشينكو وبشار الأسد.
وفي 26 شباط/ فبراير، قرّرت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا عزل بنوك ومصارف روسية عن نظام SWIFT للتعاملات المصرفية والتحويلات المالية الدولية، وتوسيع دائرة الكيانات والأفراد، القريبين من الكرملين، بما في ذلك عائلاتهم، وتجميد أصولهم التي يمكن الوصول إليها في العالم، والحدّ من قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى احتياطاته من العملات الأجنبية، والمقدَّرة بـ 630 مليار دولار. ويعدّ استهداف البنك المركزي الروسي الضربة الأشدّ التي يتلقّاها الاقتصاد الروسي، وهي ترقى إلى محاولة تقييده، عبر حرمانه من الأصول والاحتياطات لتحقيق استقرار نقدي والتخفيف من وطأة العقوبات. وتعّد هذه الخطوة غير مسبوقة، إذ إنها تُتخذ أول مرة ضد دولة كبرى مثل روسيا.
وفي 28 شباط/ فبراير انضمّت الولايات المتحدة إلى دول أخرى في فرض عقوباتٍ على صندوق الثروة السيادي الروسي، وعلى إحدى الشركات التابعة له، ما ضاعف الضغوط على الروبل الروسي الذي فقد 30% من قيمته تقريبًا خلال الأسبوع الأول من الحرب. وفي الأول من آذار/ مارس 2022، أعلن بايدن في خطاب عن حالة الاتحاد أنّ وزارة العدل الأميركية ستشكل فريقًا لتعقّب ما أسماه “جرائم الأوليغارشية الروسية”. أضف إلى ذلك أنّ واشنطن ستنضم إلى حلفائها الأوروبيين “في إغلاق المجال الجوي الأميركي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، ما يزيد من عزلة روسيا”.
حسابات المواجهة
على الرغم من تشديد الولايات المتحدة وحلفائها في “الناتو” على أنهم لن يشاركوا عسكريًا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، إلّا إذا جرى الاعتداء على دولة عضوٍ في حلف الناتو، فإنّ هذا لا يمنع وجود قلق غربي من إقدام روسيا على مزيد من التصعيد. فمن جهةٍ، بدأت العقوبات الاقتصادية تظهر على الاقتصاد الروسي، إذ انخفضت قيمة الروبل إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة إلى 20% لوقف تدهور قيمة العملة ومنع تدفّق الودائع من البنوك الروسية إلى الخارج. كما عانت أسواق الأسهم الروسية أسوأ انخفاض في تاريخها، إذ فقدت 33% من قيمتها، وإن استعادت جزءًا منها بعد ذلك، وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، تصنيف ديون روسيا بشدة أيضًا. ويتوقع اقتصاديون أن تؤدّي العقوبات على روسيا إلى إفلاس عدد من بنوكها وحدوث تضخّم هائل، ما قد يشعل فتيل اضطراباتٍ شعبية داخلية تهدّد حكم بوتين.
ومن جهة أخرى، تساعد الولايات المتحدة أوكرانيا عسكريًا؛ إذ تمدّها بمعلوماتٍ استخباراتية عن تحرّك القوات الروسية داخل أراضيها، وتزوّدها مع حلفائها بمساعدات وعتاد حربي بكميات كبيرة. وفي 27 شباط/ فبراير، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ الاتحاد الأوروبي سيموّل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وهذا ما تفعله دول أخرى في “الناتو” أيضًا. وكانت إدارة بايدن وافقت خلال عام 2021 على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار من الأسلحة نُقلت إليها في الأسبوع الأول من الحرب، مثل الصواريخ المضادّة للدبابات والطائرات. وسمحت إدارة بايدن لكييف بسحب ما قيمته 200 مليون دولار من مخزونات الأسلحة الأميركية التي جرت الموافقة عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بما في ذلك صواريخ جافلين، وتدرس تزويدها بصواريخ ستينغر المضادّة للطائرات. وقامت ألمانيا بتغيير سياستها القائمة منذ الحرب العالمية الثانية، ووافقت على تزويد أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر. وكذلك فعلت دول أوروبية معروفة بحيادها، مثل السويد، في حين قالت فنلندا إنها تدرس الأمر نفسه.
تزيد هذه الإجراءات من شعور الرئيس بوتين بالعزلة والحصار، وتخشى بعض الدوائر الغربية أن يدفعه ذلك إلى مزيد من التصعيد. وكان بوتين هدّد مع بدْء اجتياح أوكرانيا بأنّ أيّ طرف سيتدخل في الأزمة سيواجه “عواقب لم يختبرها في تاريخه”.
خاتمة
لن تثني التكلفة الباهظة للعقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها الرئيس بوتين على الأرجح عن المضيّ في بلوغ هدفه المتمثل بإخضاع أوكرانيا؛ إذ لم تنجح العقوبات في تغيير سياسات دول إمكاناتها أصغر بكثير من روسيا، كالعراق في عهد الرئيس صدّام حسين، وكوريا الشمالية وإيران وسورية. ويعدّ الاقتصاد الروسي، من حيث الحجم، الحادي عشر عالميًا، بقيمة 1.7 تريليون دولار، وهو ما يؤهله للتأثير في استقرار الاقتصاد الدولي. وعلى الرغم من أن الجيش الروسي يواجه صعوباتٍ في أوكرانيا، جرّاء افتقاده القوة البشرية اللازمة لتغطية كل مسرح العمليات الأوكراني الواسع (600 ألف كيلومتر مربع) وضعف الإمدادات اللوجستية، فإنه يبدو في وضع سيمكّنه، في النهاية، من السيطرة على المدن الكبرى، وتحديدًا العاصمة كييف، وإنْ بتكلفة أكبر مما كان متوقعًا، نتيجة الدعم الكبير الذي تحصل عليه أوكرانيا من دول الغرب.
ولن تتوقف موسكو على الأرجح قبل أن تحصل على تعهداتٍ واضحةٍ بأنّ “الناتو” لن يقوم بتوسعات جديدة على حدودها. ويبدو أنّ الكرملين يسعى، في المدى القريب، إلى انتزاع أكبر تنازلاتٍ ممكنة من أوكرانيا، مثل استقالة رئيسها وحكومتها ونزع سلاح جيشها، واختيارها الحياد. لكن، وفي كل الأحوال، سيكون ثمن اجتياح أوكرانيا كبيرًا على روسيا، جرّاء العقوبات غير المسبوقة التي فُرضت عليها، واحتمال دخولها في مستنقعٍ يستنزفها سنوات، وفي ظل عدم وجود حلفاء أقوياء لها يمكنها الاعتماد على دعمهم، باستثناء الصين. لكن الصين لم تؤيد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، رغم أنها كانت ترفض محاولات توسّع حلف الناتو في شرق أوروبا ودوره المتزايد في منطقة المحيطَين، الهندي والهادئ. وعلى الرغم من أنّ الصين أعلنت أنها لن تلتزم العقوبات على روسيا، وأنها قد تستمرّ في شراء نفطها وربما تقديم قروض لها، فإنّ التوقعات ترجّح أنّها لن تغامر بتحدّي العقوبات الغربية على نحوٍ سافر، آخذةً في الحسبان مصالحها التجارية الكبيرة مع أوروبا والولايات المتحدة أيضًا.
—————————–
مكر التاريخ: من صدّام إلى زيلينسكي/ حسن نافعة
هل يوجد وجه شبه بين الأزمة الكويتية العراقية التي اندلعت عام 1990 والأزمة الأوكرانية الروسية الراهنة؟. أوجه الخلاف بين الاثنتين كثيرة ومتنوعة، ومع ذلك، في ظني أن بينهما وجه شبه واحداً على الأقل، وهو خطأ الحسابات الناجم عن عدم قدرة كل من القيادتين، العراقية والأوكرانية، على القراءة الصحيحة للتحوّلات الجارية في النظام الدولي وقت اندلاع الأزمة، ما أدّى إلى إدارتهما لها بطريقةٍ عرّضت بلديهما وشعبيهما لمخاطر كان يمكن تلافيها، إذا ما أديرت بطريقة أكثر حكمة وعقلانية. ففي عام 1990، وجّه الرئيس صدّام حسين اتهاماتٍ إلى دولة الكويت، وادّعى أنها تسرق النفط العراقي من حقل الرميلة المشترك، وتتعمّد تبنّي سياسات نفطية تساهم في تضييق الخناق الاقتصادي على العراق، الخارج لتوّه من حرب طويلة مع إيران، كما طالب الكويت، في الوقت نفسه، بإسقاط جانب كبير من الديون التي تراكمت على العراق، بسبب الحرب التي يقول إنه خاضها دفاعا عن دول الخليج العربي كلها، وبمنح العراق تسهيلاتٍ بحريةٍ تمكّنه من تصدير النفط عبر موانئ تطلّ على الخليج مباشرة. وعندما أنكرت الكويت الاتهامات الموجهة إليها، ورفضت مطالب صدّام، أقدم الأخير على غزوها واحتلالها، بل وضمّها إلى العراق، واعتبرها المحافظة رقم 19. ولا تناقش المقالة هذه مدى مصداقية اتهامات صدّام أو مشروعية مطالبه، وإنما تبحث عن الأسس التي بنى عليها حساباته عند اتّخاذه قرار الغزو الذي تسبّب في كارثة كبرى، ليس فقط لبلاده، وإنما للعالم العربي ككل، فهل اعتقد صدّام أنه ليست لدى الولايات الرغبة في التدخل، أم تصوّر أن بمقدوره الاعتماد على الاتحاد السوفييتي، الذي لم يكن قد انهار رسميا بعد، بتقديم غطاء سياسي يكفي لردع الولايات المتحدة وإجبارها على عدم التدخل؟
الواقع أن كل التحولات الجارية في النظام الدولي وقت اندلاع أزمة 1990 كانت تغري الولايات المتحدة ليس فقط بالتدخل العسكري، وإنما أيضا لتوظيف هذه الأزمة لخدمة أهداف استراتيجية أميركية عليا، تتجاوز الأهداف المعلنة بالضغط على صدّام للانسحاب من الكويت، كما كان من شأن هذه التحولات، في الوقت نفسه، شل قدرة الاتحاد السوفييتي على فعل أي شيء للحيلولة دون وقوع حرب، أو لاحتواء تأثيراتها المحتملة ومحاصرتها، أو لمدّ يد العون إلى صدّام. صحيحٌ أن الاتحاد السوفييتي لم يكن، في ذلك الوقت، قد سقط أو تفككك رسميا بعد، لكن كان من الواضح أنه يمرّ بأكثر أوقاته صعوبة وضعفا. يجدُر بنا هنا أن نتذكّر أن الأزمة بين العراق والكويت اندلعت بعد عام كامل من سقوط جدار برلين، وهو حدثٌ اعتبره كل خبراء العلاقات الدولية وقتها مؤشّرا على انتهاء حالة الحرب الباردة بين المعسكرين، الشرقي والغربي. وبعد أكثر من عام على انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، أو بالأحرى هزيمته هناك، وبعد انعتاق معظم دول أوروبا الشرقية من الهيمنة السوفييتية وبداية تفكك حلف وارسو.. إلخ، وكلها مؤشّرات كانت تدل، بوضوح، على أن مرضا عُضالا أصاب الاتحاد السوفييتي وشلّ قدرته على الفعل، وبالتالي فالرهان عليه خاسر لا محالة. لذا، أتاح الاحتلال العراقي للكويت، في هذه اللحظة تحديدا، فرصة تاريخية فريدة أمام الولايات المتحدة، ليس فقط للتعجيل بانهيار الاتحاد السوفييتي من خلال إظهار عجزه عن إنقاذ النظام العراقي الحليف، ولكن أيضا لانتزاع اعتراف عالمي بأنها (الولايات المتحدة) باتت الدولة الوحيدة القادرة على الهيمنة المنفردة على النظام العالمي، من خلال استعراض عضلاتها العسكرية في “حرب تحرير الكويت”. ولا جدال في أن هذا الخطأ في حسابات صدّام كلّف العراق غاليا، وكان بمثابة الخطوة الأولى التي مهّدت لغزوه واحتلاله أميركيا عام 2003.
إذا طوينا صفحة الأزمة العراقية الكويتية، وفتحنا صفحة الأزمة الأوكرانية الراهنة، نجد أن السبب المباشر في اندلاعها يتعلق برفض روسيا القاطع طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو واعتباره خطرا مباشرا على أمنها القومي، وهو ما كان معلوما للكافة قبل سنوات طويلة من وصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى السلطة عام 2019، فمعروف أن قمة رؤساء دول وحكومات حلف الناتو في بوخارست، في إبريل/ نيسان 2008، أصدرت إعلانا عبّرت فيه عن “ترحيبها بالتطلعات الأوروبية الأطلسية لكل من أوكرانيا وجورجيا اللتين ترغبان في الانضمام إلى الحلف”. وأشارت فيه إلى خطوات قالت إنها “ستقودهما مباشرة إلى عضوية الحلف”. ويبدو أن هذا الإعلان شجّع حكومة جورجيا على شن هجوم على إقليم أوسيتيا الجنوبية الرافض سياستها في ذلك الوقت، ما استدعى تدخلا عسكريا روسيا فوريا، انتهى بخسارة جورجيا كلا من أبخازيا وأوسيتيا، في مؤشّرٍ لا تخطئه العين على أن روسيا الاتحادية بدأت تستعيد قوتها المفقودة، وأنها لن تقبل من الولايات المتحدة والدول الغربية، من الآن فصاعدا، ما كانت مضطرّة لقبوله من قبل، خصوصا ما يتعلق بتوسع “الناتو” شرقا، وعلى وجه أخص ما يتعلق بانضمام جورجيا وأوكرانيا تحديدا لهذا الحلف. وحين بدت الولايات المتحدة والدول الغربية وكأنها كسبت جولة في صراعها المتواصل بشأن أوكرانيا، حين تمكّنت من إطاحة النظام الموالي لروسيا هناك من خلال “ثورة ملوّنة”، سارعت روسيا بالرد على التحدّي، واندلعت أزمةٌ سرعان ما تحوّلت إلى صراع مسلح، انتهى بإقدام روسيا على ضم شبه جزيرة القرم، وبدفع إقليمين أوكرانيين تقطنهما أغلبية روسية نحو الانفصال، وهما اللذان اعترفت موسكو بهما جمهوريتين مستقلتين. وكان هذا بمثابة مؤشّر آخر على تصميم روسيا على الرد على المحاولات الغربية التي تهدف إلى تحويل كل من جورجيا وأوكرانيا، الجارين والعضوين السابقين في الاتحاد السوفييتي، إلى دولتين معاديتين على حدودها الغربية، وبدا واضحا أنها قرّرت أن ترسم حول حدودها الشرقية خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها.
في سياق ما تقدّم، كان على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، عندما وصل إلى السلطة عام 2019، أن يدرك أن النظام الدولي قد تغير، وأن التاريخ بدأ يسطّر صفحة جديدة من صفحات مكره الذي يستحيل التنبؤ به!. فروسيا الحالية، المستعدّة لتحدي الغرب ولوقف تمدّد “الناتو” شرقا، ليست هي الاتحاد السوفييتي في التسعينيات، والولايات المتحدة، المهزومة في أفغانستان، والمنسحبة منها قبل أشهر قليلة من اندلاع الأزمة الأوكرانية الراهنة، ليست هي الولايات المتحدة التي كانت تتفاخر بقدرتها على خوض حربين متزامنتين على جبهتين مختلفتين في بداية القرن. لو كان زيلنسكي قد أدرك هذه الحقيقة، لتبنّى سياسة أكثر حكمةً تهدف إلى تهدئة هواجس روسيا الأمنية، ترتكز على حياد أوكرانيا وإعلان قبولها الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا، والاكتفاء بطلب قبولها عضوا في الاتحاد الأوروبي بدلا من حلف الناتو، بل وربما كان من مصلحته ومصلحة بلاده السعي إلى أن تكون أوكرانيا جسرا للتواصل بين روسيا والغرب، عبر صيغة أمن مشترك يقبلها الطرفان، وليس ساحة للصراع بينهما. لكن ما فعله الرجل كان عكس ذلك تماما، فحتى بعد أن كشّرت روسيا عن أنيابها، وبدأت تحشد قواتها العسكرية على حدودها مع أوكرانيا، واصل إصراره على طلب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وقبل أن يتحوّل إلى دمية في يد الغرب، حتى لو كان الثمن تعريض بلاده للغزو العسكري، وهو ما جرى فعلا، فعلى أي شيء راهن زيلينسكي؟
من الصعب التكهن منذ الآن بما ستؤول إليه الأزمة الأوكرانية التي بات مؤكّدا أنها ليست أزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنما أزمة عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، طرفاها روسيا: المدعومة صينيا وإيرانيا، من ناحية، والولايات المتحدة: المدعومة أوروبيا وغربيا، من ناحية أخرى. ولأنه يستحيل، في تقديري المتواضع على الأقل، أن تسفر المواجهة الراهنة عن هزيمة أي من طرفي الأزمة هزيمة كاملة، أعتقد أنه بات في حكم المؤكّد أنه عندما تصمت المدافع، سيكون ميزان القوى الدولي قد تحرّك إلى نقطة توازن تختلف كثيرا عن التي هو عليها الآن. لذا، أرجّح أن تسفر الأزمة عن ولادة نظام متعدّد القطبية، بدلا من النظام الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة منفردة أو بالتحالف مع القوى الغربية. لكن قبل ذلك ستكون أوكرانيا قد تحوّلت إلى ركام، وتحت قيادة جديدة غير قيادة الكوميديان فولوديمير زيلينسك
——————-
البحث عن نظام عالمي جديد/ بيار عقيقي
تحدّث كثر عن “نظام عالمي جديد”، يُفترض أن يولد من رحم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي. اتهم الغربيون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالعمل على تغيير قواعد اللعبة المعمول بها منذ تفكّك الاتحاد السوفييتي في عام 1991. ومع أن هذا البلد كان جزءاً من هذا النظام الذي جمع المنتصرين في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، إلا أنه كان “الجار المزعج” الذي منع تفرّد الجزء الآخر من المنتصرين في قيادة العالم. وبعد سقوطه، تحوّلت قواعد اللعبة، وجرى تعديل النظام إلى قطبية أميركية برضى أوروبي. الآن، وإن كان بوتين يرغب فعلياً بإعادة توزيع الأدوار ضمن منطق “التعدّدية القطبية”، بما يهدّد النظام الحالي، إلا أن الغرب بدوره يدرك أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد تعديلات 1991، لم يعد صالحاً. لذلك، لم يأتِ الموقف البريطاني عن عبث، بالدعوة إلى إقصاء روسيا من مجلس الأمن، بما يعنيه ذلك من سحب حق “الفيتو” منها، بل أفصح البريطانيون، بصوت عال، بما يفكر به العالم الغربي: نظام عالمي جديد، تكون فيه روسيا مختلفة عن “بوتينيتها”، أي أن تكون “لاعباً آخر” لا “محوراً” في النظام الجديد.
يمكن للغرب الاعتقاد أن لجم روسيا، مرّة واحدة ونهائية، سيسمح بعدم ولادة بوتين جديد أو جوزيف ستالين وفلاديمير لينين آخرين. لكن في المقابل، وبما أن الفرضيات تبقى أوهاماً حتى تصمت آخر رصاصة في أي حرب، كيف سيكون شكل “النظام العالمي الجديد”؟ ما يظهر على الحدود البولندية – الأوكرانية يثير الرعب، لجهة التفريق بين الأوروبيين والغربيين من جهة والأفارقة والآسيويين والعرب من جهة أخرى. ليس تفصيلاً ما يحصل، لأن الإنسان في لحظة تحرّك الغريزة يصبح “حقيقياً”. وإذا كانت “الحقيقة” تعني إبقاء النظرة التسلطية الحديثة التي أرستها قرون الاستعمار الأوروبي إلى دول أفريقية وآسيوية وأميركية، فإن مشكلة العنصرية لن تبقى مجرّد “مسألة هامشية”، بل ستتحوّل إلى معضلة عالمية، خصوصاً أن دولا أفريقية عديدة، في مقدمتها نيجيريا، ستتحوّل إلى كتلة ديموغرافية كبيرة في العقود المقبلة، ما يضع أفريقيا على رأس أكبر القارّات بعدد السكان.
والديموغرافيا ليست بيدقاً صغيراً في رقعةٍ سياسيةٍ، بل محورا أساسيا بفعل النمط الاقتصادي المبني على التوجه إلى أسواق ذات كثافة سكانية، والذي نما بصورةٍ هائلةٍ في قلب نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. هنا، تبدو العنصرية الموجهة ضد العرب والأفارقة والآسيويين محفّزا لخلافٍ مؤجل، أكبر بكثير من محاولة طمسه بسبب ضجيج الغزو الروسي. إذاً، في أثناء سعي الغرب، وضمن منطق عنصري، إلى إبعاد الروس وكل ما يمتّ إلى روسيا عن الأنشطة الرياضية والموسيقية والثقافية وغيرها، بغية إخراج بوتين من أوكرانيا، فإنه يستولد خصماً مستقبلياً سيكون جاهزاً في “ساعة صفر” لمواجهته. حينها، لن يكون “النظام العالمي” الذي يحاول استغلال شجاعة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم في منأى عن خطر أكبر من روسيا.
هل يدرك الغرب المخاطر الناجمة عن الغزو؟ أكيد لا، لأن الإعلاميين الذين تحدّثوا بفوقية تجاه كل ما هو غير غربي لم يولدوا أمس، بل هم جزءٌ من نسيج، لا تهمّ نسبته المئوية في المجتمع بسبب تأثيره وقدرته على إيصال صوته، يعتقد أن أفكاره الخاطئة تجاه غير الغربيين “صحيحة”. هنا، تبدو الأزمة أكثر تعقيداً وتمسّ بجوهر الأفكار التي سعى بعض فلاسفة ما بعد الثورات الشبابية والثقافية في الستينيات إلى تسويقها. وتتلخّص الأفكار بـ”النظر إلى الآخر كما ننظر إلى أنفسنا”. لذلك، يبدو أن نحو نصف قرن من محاولة تغيير عقليةٍ رسّختها القرون الوسطى قد ذهبت سدى، ونال أصحاب التيارات اليمينية المتطرّفة أكثر مما يشتهون. هل يمكن بناء “نظام عالمي جديد” وفق هذه التصوّرات؟ لا، بل شكل متجدّد من “كو كلوكس كلان”.
العربي الجديد
—————————
احتلال أوكرانيا وإمكانية الحرب العالمية الثالثة/ عمار ديوب
يراقب العالم الحرب في أوكرانيا. يريد الروس احتلال هذا البلد كاملا، والمقاومة الأوكرانية تحاول تأجيل ذلك. الفرق بين الجيش والمقاومة ومعها الجيش الأوكراني يقول إن روسيا سائرة نحو الاحتلال. الدعم العسكري الأطلسي ليس قادرا على دعم مستمر للمقاومة الأوكرانية. وعلى الرغم من كثرة الحدود بين دول أوروبا الشرقية وأوكرانيا، فإن روسيا، ومعها بيلاروسيا، مصرّتان على ذلك الاحتلال، وستُوقفان ذلك الدعم، أو تخفّفان من وصوله. لا يمكن إلّا تأييد حق الأوكرانيين في مقاومة الاحتلال؛ هكذا يجب تسميته، رغم الاستراتيجيات المتباينة بين الروس والأميركيين والأوروبيين بما يخص الضمانات الأمنية التي طلبها الروس ورفضتها الدول السابقة، ما دفع الروس نحو خيار الاحتلال والتهديد بالسلاح النووي.
ليست أوكرانيا الهدف من الاحتلال الروسي، إنما هو تشكيل نظام عالمي جديد، يكون للروس دور مهيمن فيه، وقد توسّعوا في جورجيا وكازاخستان والقرم، وعملوا على تطوير دولتهم بشكل كبير بدءا من عام 2000. الهدف الكبير هذا ترفضه الولايات المتحدة التي لا ترى روسيا إلّا دولة إقليمية بعد زوال الاتحاد السوفييتي. تخشى الإدارة الأميركية فعلياً الصين، والمواقف الغربية من الاحتلال تُواجَه بمواقفٍ من طراز أن روسيا ليست دولة عالمية وعليها الانكفاء، ولكن هل يمكن الاستمرار في مواقف كهذه، سيما بعد التهديد بالنووي، والإصرار على أخذ أوكرانيا وبأعلى الكلف البشرية والاقتصادية والعزلة السياسة. أميركا وأوروبا تتجهان نحو التصعيد، عبر دعم أوروبا الشرقية بالسلاح وبالمقاتلين، وتشديد العقوبات الاقتصادية، وربما الاستغناء نهائياً عن الطاقة الروسية، وعزلها مالياً بشكل كامل، وكذلك تشديد العقوبات على الدول المتحالفة مع روسيا. هذا تصعيدٌ خطير، يضع روسيا في الزاوية، وبعيداً عن التحليلات التي ترى أن بوتين “مالك” روسيا، وأن قرار الحرب يخصّه وحده. هذا كلام يتجاهل كل ما أشرنا إليه، ويتجاهل تهميش الغرب روسيا بعد المرحلة السوفييتية، وبالتالي الحرب والتوسّع والتهديد بالنووي هو خيار القيادة الروسية، ومن دون شك، لبوتين دور أساسي فيها.
مرّ أكثر من أسبوع على العدوان على أوكرانيا، وحتى الآن يؤكد قادة الغرب أنهم لن يتورّطوا بحربٍ مع روسيا، ولن يفرضوا حظراً جوياً على أوكرانيا، ولن يتدخلوا عسكرياً، وهذا يعني أن الحرب لن تخرج من أوكرانيا. وبالتالي، سيتعمق الخلاف بين الروس والأوكرانيين أكثر فأكثر، وقد تتحوّل أوكرانيا بالفعل إلى مستنقع.
روسيا الآن في ورطة كبيرة، وقد تحسم المعركة في كييف وتضع نظاماً جديداً، ولكن المقاومة هنا لن تتوقف أبداً، والغرب مصرٌّ على استنزافها؛ فالبلاد تُدمّر كل ساعة، وعدد الضحايا في ارتفاع، وهذا يعني أن على روسيا التفكير بأكثر من نظامٍ موالٍ، فهل هذا ممكن؟ إن تجربة بيلاروسيا، ودعم لوكاشينكو لا يشجّعان كثيراً، والتدخل الأخير في كازاخستان أيضاً يقول بهمجية القيادة الروسية، وسياساتها تتحدّد بشطب أية أفكار تخصّ الحريات والديمقراطية، أي عكس التجربة الأوكرانية ورغبة هذا الشعب بخيار الديمقراطية والاستقلال والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
أوكرانيا، كما سورية، إلى دمارٍ كبير، وإلى أزمة لجوءٍ واسعة نحو أوروبا، وإلى مستنقع حقيقي للروس، لم يعانوه في سورية، وأوكرانيا ليست أفغانستان، فهي في قلب روسيا التي ستتضرّر بشكلٍ كبير من ذلك، ولكنها تنطلق، وقبل الحرب، من أن الخطر ليس في أوكرانيا، بل من حلف شمال الأطلسي. هذا الاعتبار، والتهديد بالنووي، سيضعان أوروبا وأميركا ضمن خيارات محدّدة: التفاوض مع روسيا، وإيجاد حل لمستقبل أوكرانيا ووفقاً لما يريده الروس، وبديمقراطية هامشية، والتخفيف من البنية التحتية للناتو، أو أن الحرب العالمية الثالثة واقعةٌ لا محالة. الخيارات هذه ستجبر أوروبا، الخاسرة أيضاً من الحرب الأوكرانية، ومن إيقاف موارد الطاقة إليها، وسواه، على أن تتخذ مسافة عن السياسات الأميركية؛ هي الآن، اتحدت تحت الهيمنة الأميركية، وحلف الناتو اشتدّ عوده بعد أن نعاه ترامب وماكرون. ومن الخطأ أن نغفل الخطوة الألمانية في تخصيص مائة مليار دولار لتطوير البنية العسكرية، ولكن حين تقع الحرب، ستكون المتضرّر الأكبر بالتأكيد، والآن ترى مصير أوكرانيا، سيما أن الروس لم يستخدموا بعد كل قوتهم العسكرية، وحين تصبح الحرب عالميةً، لن يتورّعوا عن ذلك.
روسيا المتألمة بقوة من التهميش الأميركي، والذي كان، كما السياسات الخاطئة للقيادة الروسية، من أسباب تفكيك العلاقات القوية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، تجد نفسها مجبرةً على تهديد “الناتو” وأوروبا، ولن يقف جيشها في أوكرانيا، ولكنه أيضاً لن يتحرّك نحو أوروبا الشرقية أو دول البلطيق في اللحظة الراهنة. الآن، “الناتو” وروسيا يتقابلان عند حدود أوكرانيا، وإمكانية إشعال الحرب قائمة؛ فروسيا مستعدّة لها وتزداد عزلتها وحصارها، وأوروبا و”الناتو” يشحذان الأسلحة، ولكن هناك أيضاً نوافذ قوية للتفاوض، وهناك الصين، و”تشنّج” العلاقات الدبلوماسية، لن يعدم طرقاً للتفاوض بين الغرب وروسيا.
الحرب على أوكرانيا، في قلب روسيا وأوروبا، حيث بدأت الحربان العالميتان السابقتان، وحيث الهيمنة على العالم، وحيث الدول الأكثر تطوّراً، وهذا يعني أن العالم، بعد احتلال أوكرانيا، لن يكون كسابقه. لقد أصبحت رغبة روسيا في نظامٍ عالميٍ جديد على طاولة الدول الأكثر هيمنة على العالم، وهي فرصةٌ أيضاً لها لتغيير قواعد الهيمنة الأميركية السابقة، وروسيا لن تكتفي بالمفاوضات من أجل مستقبل أوكرانيا. لم تعد خطوات روسيا بالتقدّم التدريجي نحو محيطها الأوراسي وفي سورية، والشرق الأوسط بعامة، تكفي، والصين التي ما تزال تحاول الهيمنة اقتصادياً، وترفض جرّها إلى تأزمٍ عسكري، بدأت أميركا بالإعداد له، عبر حلف أوكوس، لن تخذل روسيا على الرغم من اتخاذها موقف الحياد إزاء غزو روسيا.
الصين وروسيا الآن حليفان اقتصاديان كبيران، والصين بحاجة لها بسبب موارد الطاقة والصناعات العسكرية، وتتفقان في شكل الحكم الاستبدادي، ورغبة الصين في دعم روسيا لها بحقها في تايوان، وأن تكون قطباً عالمياً، وهناك دول تابعة لروسيا في العالم، وليست فقط كوبا وسورية وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران.
روسيا تتعثر في أوكرانيا، ولكنها ستحتلها، وشروطها ما تزال على الطاولة إزاء تفكيك البنية التحتية لحلف الناتو في أوروبا الشرقية. وفي أوكرانيا تقوم بتدمير ممنهج لتلك البنية وللجيش الأوكراني. وبعد فرض العقوبات، سيكون رفعها من ضمن تلك الشروط؛ الوحدة الأوروبية الأميركية في حلف الناتو ولمواجهة روسيا ليس هو الرد المناسب، بل يؤجّج سباق التسلح، وربما الحرب، التي اختبرت نتائجها أوروبا جيداً؛ الخيارات أمام الروس والغرب والعالم أصبحت محدّدة، فهل يتّجه العالم نحو حرب عالمية ثالثة، أم نحو تعدّدية قطبية، أم أن الأخيرة غير ممكنة من دون الحرب؟
العربي الجديد
——————————
من اجتياح أوكرانيا إلى «نهاية العالم»؟
أدى هجوم القوات الروسيّة، أمس، على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، إلى اشتباك مع حرس المنشأة واندلاع حريق قربها، مما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى التحذير من «نهاية أوروبا» في حال انفجار الموقع الذي يحتوي أكبر محطة نووية في أوروبا، ويحوي ستة مفاعلات ذرية.
حصلت الواقعة في مبنى للتدريب قرب المحطة (والذي تبلغ مساحته ألفي متر مربع)، وسمحت القوات الروسية، بعد تردد، لعناصر الإطفاء بالدخول بحيث تمكنوا من السيطرة على النار، كما أن العاملين في المحطة قاموا بفصل بعض الوحدات النووية وتبريد الوحدات الأخرى، وأكدت سلطات كييف، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد هذا الفاصل الدرامي المثير، عدم رصد أي تغير في مستوى الإشعاعات عقب القصف.
رغم السيطرة على الخطر النووي فإن العملية استدعت ردود فعل كبيرة تتناسب مع جسامة الحادثة، فأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع «مركز الحوادث والطوارئ في وضع الجاهزية الكاملة»، وأن «الوضع متوتر للغاية ويمثل تحديا»، واعتبر زيلينسكي استهدافها «عملا إرهابيا قد تنجم عنه كارثة أكبر بأضعاف من تشيرنوبل»، وأدان أمين عام حلف الناتو «الهجوم الطائش»، وأعربت فنلندا، البلد المجاور المحايد، «ذعرها من القتال بالقرب من محطة نووية»، فيما قالت رومانيا إن على حلف الأطلسي «التكيّف مع الواقع الجديد»، وهو ما فُهم كدعوة لوجود دائم لقوات الحلف على الجبهة الشرقية لروسيا.
من الواضح أن الجيش الروسي، في سعيه إلى احتلال مواقع الطاقة الاستراتيجية، والتي تشكل المحطات النووية الأربع في أوكرانيا التي توفر نصف الكهرباء في البلاد، أهم مواقعها، يمشي على خطة تقليدية للسيطرة على البلاد والتحكم في مواردها الكبرى، كما يتفاعل، من جهة أخرى، مع قائمة عناصر الدعاية الحربية التي استخدمتها موسكو لتبرير هجومها على أوكرانيا، بدعوى أنها قد تشكل خطرا نوويا عليها.
من المثير للتفكر، في هذا السياق، أن أوكرانيا كانت تعتبر القوة النووية الحربية الأكبر في العالم، بامتلاكها قرابة 1700 صاروخ نووي، وأنها تخلّت عن هذه الصواريخ النووية عام 1994 بناء على اتفاقية بودابست، التي ضمنت فيها روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، أمن أوكرانيا.
النتيجة أن روسيا، إحدى الدول الضامنة، تنكّرت لتوقيعها وقامت بالهجوم على أوكرانيا، وأن القوى الدولية الكبرى أيضا، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، لم تحترم التزامهما بضمان أمن أوكرانيا ومنع احتلالها، كذلك لم يمنع كل هذا روسيا من تهديد الغرب، علنا وصراحة، بأسلحتها النووية.
آخر التصريحات التي صدرت على لسان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، هي أن بلاده «مستعدة للحرب»، في حال تعرضت، أو أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي، لهجوم، ورغم أن هذا التصريح يدخل في باب البداهة لكنّه، في ظل التهديدات النووية الروسية، والهجوم على محطة زابوريجيا، والسيطرة قبلها على محطة تشيرنوبل، التي تعتبر مثالا على أخطر حادثة لمفاعل نووي في العصر الحديث، يرفع منسوب احتمالات حصول حدث آخر تنفلت فيه الأمور عن سكتها.
أحد السيناريوهات الممكنة لهذا الحدث هو أن تقوم القوات الروسية كأسلوب حربي للضغط على الأوكرانيين، بوقف عمل المفاعلات النووية الستة الموجودة في المحطة، وذلك لقطع ما يعادل 20% من كهرباء أوكرانيا، وبما أن المفاعلات تحتاج تبريدا بالماء، وهو ما يحتاج طاقة كهربائية، فإن اللجوء لأنواع من الوقود، كالديزل، لتشغيل المولدات الاحتياطية، وهو ما سيعزز مخاطر الحوادث، ويرفع احتمال حصول حادث نووي خطير.
السيناريوهات الأخرى تتضمن طبعا حصول مجابهة عسكرية بين روسيا و«الناتو»، ولا أحد، في هذه الحالة، سيعرف إذا انتهت تلك المواجهة بـ«نهاية أوروبا» أم بنهاية العالم كله.
القدس العربي
————————–
عن “نجاحات” بوتين في مغامرته الأوكرانية / ماجد كيالي
سوريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا، فقط، هي التي وقفت إلى جانب روسيا بوتين في حربها على أوكرانيا، في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً، فحتى إيران وفنزويلا وكوبا، مثلاً، نأت بنفسها بامتناعها عن التصويت، بين مجموعة من الدول (بينها الصين والهند)، في حين أيدت قرار إدانة تلك الحرب 141 دولة.
وفي الواقع فإن هذا التصويت يكشف صورة روسيا وحجمها ووزنها على الصعيد الدولي، في الحقبة البوتينية، علماً أنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وأكثر دولة لديها ثروات باطنية، لكنها مع ذلك لا تعد من الدول العشر الأولى في العالم (دخلها السنوي أقل من 2 ترليوني دولار)، في القوة الاقتصادية، واللافت أن كندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية تتفوق عليها، ما يفيد بأن مشكلة روسيا تكمن في شكل إدارتها، وطبيعة نظامها السياسي، وفي الخيارات التي تنتهجها قيادتها، في علاقتها بشعبها، وفي علاقاتها بدول العالم.
الآن، وبغض النظر عن الجدل في شأن وجاهة الحرب الروسية في أوكرانيا أو مشروعيتها، من عدم ذلك، يمكننا ملاحظة أن تلك الخطوة لم تكن حكيمة، ولا مدروسة جيداً، إذ كان بالإمكان انتهاج سياسات أخرى، ووسائل ضغط أخرى، لتأمين مصالح روسيا، وتخفيف مخاوفها.
هكذا، فإن مشكلة روسيا على هذا الصعيد إنها بلد يديره فرد بمعزل عن أي مؤسسات أو إطارات، لا سيما أن ذلك الرجل مسكون بهاجس عظمة روسيا، وبالروح العسكرية الروسية، وبطموحه إلى فرض روسيا كقطب أو كدولة عظمى، في عهده.
بيد أن مشكلته في هذا الاتجاه تكمن، أيضاً، في أنه لا يملك الوسائل اللازمة لذلك، ولو بالحد الأدنى نسبة الى ما تمتلكه الولايات المتحدة أو الصين أو اليابان أو ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا، مثلاً، وأنه لا يمتلك وسائل ضغط ناعمة، أو غير مباشرة، لإنفاذ سياساته (كما تفعل الولايات المتحدة عقاباً له)، وأن الدولة في عهده لم تستطع أن تفرض مكانتها كقطب دولي، بالقياس لما استطاعته الصين، المنافسة لأميركا، مثلاً، من دون وسائل عسكرية، أي بوسائل التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي، وبما تصدره للعالم.
وفقاً للاعتبارات السابقة فإن بوتين يدرك أنه لا يستطيع فرض روسيا دولة عظمى بالوسائل الطبيعية، الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والتبادلات التجارية وقوة النموذج السياسي والثقافي، وأن هذا الأمر يحتاج منه للاستثمار في القوة العسكرية، كما فعل سابقاً في الشيشان (1999) وجورجيا وأوكرانيا (2014)، وسوريا (2015) وصولاً إلى ليبيا أخيراً.
في هذا السياق يحاول بوتين ابتزاز العالم بمسألتين: الأولى، تهديد الدول المجاورة باحتلالها أو الهيمنة عليها بالقوة والقسر، وهي دول ضعيفة أساساً، وجزء كبير من ضعفها اقتصادياً وعسكرياً، يعود لعدم سيادتها على ذاتها في الحقبة السوفياتية، وربما في الحقبة الروسية الأسبق، أيضاً. والثانية، التلويح بامتلاكه السلاح النووي، ما يفسر إعلانه وضع الأسلحة النووية الروسية على أهبة الاستعداد. وهو في هذا وذاك يشرح للعالم أنه كرجل خطير ليست لديه خيارات، فإما إرضاء غطرسته وطموحه، أو الطوفان.
في محصلة تلك المغامرة، أو الحرب، “نجح” بوتين، حتى الآن، في تحقيق الآتي:
أولاً، إحياء حلف “الناتو” بعدما كاد هذا الحلف يدخل عالم الإهمال أو النسيان، إلى درجة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب طالب بالتخلص منه، وتساءل عن مبرر الإنفاق أو الإبقاء عليه.
ثانياً، إيقاظ الروح العسكرية الألمانية، فبعدما اطمأنت ألمانيا إلى عالم خالٍ من الحروب، مركزة على مكانتها كدولة فاعلة في التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية، وكقاطرة للاتحاد الأوروبي، إذا بها ترى نفسها في عالم لا يزال يعتمد القوة، ما جعلها تخصص 100 مليار دولار للإنفاق العسكري (2 في المئة من ناتجها السنوي)، بل وتبعث أسلحة إلى أوكرانيا بعدما تمنعت عن ذلك، هذا فضلاً عن تجميدها خط الغاز الروسي نورستريم 2.
ثالثاً، عززت الحرب من اعتمادية الدول الأوروبية على الولايات المتحدة بوصفها القوة العسكرية العظمى في العالم (تنفق 700 مليار دولار سنوياً، ما يساوي 40 في المئة من الإنفاق العالمي)، في حين كانت في السابق تحاول شق طريق مستقل لها.
رابعاً، أثارت الحرب مخاوف الدول الأوروبية التي ذاقت ويلات الحربين الأولى والثانية، من روسيا، ومن سعيها لاستخدام قوتها العسكرية لفرض إملاءاتها السياسية.
خامساً، نجحت الحرب البوتينية في زرع إسفين كبير بين الشعبين الروسي والأوكراني، ربما سيحتاج جسره إلى عقود، بل إن تلك الحرب ساهمت من حيث لا يدري صاحبها بتخليق أمة أوكرانية بتاريخ جديد أو بحدث مؤسس هو هذه الحرب.
سادساً، الحرب ربما ستؤدي إلى زعزعة ما يسمى الخيار الأوراسي الذي يراود بعض السياسيين الروس، لأن هذا المشروع يقوم على الغلبة العسكرية، وعلى إبقاء هيمنة الروس على باقي الشعوب، ولا شك في أن النموذج الموعود في أوكرانيا، في حال نجح بوتين في مسعاه، لن يلعب لمصلحة الفكرة الأوراسية المتخيلة.
هذه بعض الملامح الأولية لنتائج الحرب البوتينية في أوكرانيا، وكما يقال، فإنك يمكن أن تبدأ حرباً لكن من الصعب معرفة نهايتها، أو طريقة الخروج منها، أو تداعياتها المباشرة وغير المباشرة، القريبة والبعيدة، وهذا أكثر شيء ينطبق على هذه الحرب التي سيخرج منها المنتصر، أو الأقوى، خاسراً، حتى لو ربح المعركة، وما نشهده من عزلة روسيا، وتعرية ضعفها أمام العالم بوسائل غير عسكرية هو مؤشر كبير الى ذلك.
كان يمكن لبوتين أن يتعظ من انهيار الاتحاد السوفياتي، لدخوله أو استدراجه في مغامرة حرب النجوم، التي استنزفته، وهو لم يَنهَر في حينها لا نتيجة تظاهرات شعبية من داخله، ولا نتيجة حرب شنتها دولة من خارجه، إذ انهار بسبب العورات التي اكتنفته، وبسبب ضعفه في كل المجالات الأخرى (عدا العسكرية!). كما كان يجب أن يتعظ من تحول الدول التي كانت في عهدة الاتحاد السوفياتي، أو في منظومة الدول الاشتراكية، نحو الغرب، وليس نحو روسيا، لكن الرجل المسكون بالماضي، وبالغطرسة لن يبالي بشيء، فهو لديه سلاح “يوم القيامة”.
النهار العربي
———————————-
هذا الغزو الدموي يحول مسيرة التاريخ إلى سباق سريع – وهو لا يسير في طريق بوتين/ جوناثان فريدلاند
لقد حددت الأيام القليلة الماضية مكانة أوكرانيا في المخيلة العالمية – وبالنسبة لروسيا ، هذه مشكلة كبيرة
“بالفعل ، التحدي الجماعي والشجاعة الأوكرانيين في مواجهة خطر مرعب هو مادة الأسطورة.” جنود ومتطوعون أوكرانيون يعدون أكياس الرمل للحواجز في كييف يوم الخميس. الصورة: يوروبا برس نيوز / يوروبا برس / جيتي إيماجيس
حistory اقتحم العدو. التغييرات التي كان يتصور أنها من عمل أجيال ، أو حتى قرون ، حدثت في أيام. لقد جاءت التحولات الجيوسياسية التي سيستمر تأثيرها لعقود في غضون ساعات. جميع الحروب متسارعة ، لكن غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا يعيد تشكيل العالم أمام أعيننا.
يطالب التاريخ الغرب بنشر كل سلاح قانوني ومالي ضد بوتين
ميخائيل خودوركوفسكي
ابدأ بالهوية الوطنية. الطريقة التي ترى بها الأمم نفسها ، وينظر إليها الآخرون ، من المفترض أن تكون مادة التطور: بطيئة وتدريجية ، تضاف الطبقات بزيادات. ومع ذلك ، فإن محاولة روسيا الوحشية لابتلاع جارتها قد غيرت شيئًا عميقًا في أكثر من أسبوع بقليل.
عندما عرض بوتين حجته للحرب ، استند إلى الادعاء بأن أوكرانيا ليس لديها تقليد لـ “دولة حقيقية” . كان هذا جسيمًا ، لكنه أظهر تحيزًا لم يخترعه بوتين. قبل فترة طويلة من القومية العرقية الروسية اليوم ، تم التعامل مع أوكرانيا على أنها أقل من أمة. في القرن العشرين ، وقعت بين دكتاتوريات العصر ، التي تعرضت للضغط والدماء من قبل كل من النازية والبلشفية. حتى في الشركة الغربية المهذبة ، استمر الرأي القائل إنها مجرد منطقة في مكان آخر: فقد عاشت ، ربما دون وعي ، في أولئك الذين أطلقوا عليها اسم “أوكرانيا”.
انتهى ذلك قبل أسبوع. اكتسب الأوكرانيون مكانة جديدة في المخيلة العالمية ، باعتبارها تجسيدًا لروح الاستقلال الوطني. إن تحديهم الجماعي وشجاعتهم في مواجهة خطر مرعب هو بالفعل مادة الأسطورة – راقصو الباليه يمسكون بالبنادق ، وعلماء البيانات يحفرون الخنادق – التي ستُحاك في قصة وطنية سيخبرها الأوكرانيون لأنفسهم لقرون. حتى عندما يتلاشى ذلك في التاريخ بالنسبة لبقية العالم ، ستبقى حقيقة واحدة: الاقتناع الراسخ بأن أوكرانيا أمة ، أمة “حقيقية” بالكامل. اعتبر ذلك مجرد أول طريق من بين العديد من الطرق التي هزمت فيها مهمة بوتين نفسها بالفعل.
البعض الآخر غير متوقع على الإطلاق. في الآونة الأخيرة ، قبل أسبوعين ، وبسبب تأديبها لماضيها ، كان موقف ألمانيا الثابت هو أنها لن تلعب أي دور في حرب في أوروبا. الآن ، إشادة بـ “نقطة تحول في تاريخ قارتنا” ، ترسل المستشارة الألمانية صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة أوكرانيا ، وزيادة الإنفاق الدفاعي لبرلين بشكل كبير. كان هناك وقت كان فيه احتمال إعادة تسليح ألمانيا سيؤدي إلى حدوث هزات في أوروبا وخارجها. لكن المؤرخ الإسرائيلي الأكثر مبيعًا ، يوفال نوح هراري ، وصف هذا الأسبوع القيادة الألمانية في المعركة الحالية ضد العدوان الروسي بأنها “أفضل تكفير” عن جرائم النازيين. قال هراري ، لم يكن هذا وقتًا للبقاء على الحياد أو البقاء على الهامش: “ما نحتاجه من ألمانيا هو أن نقف شامخين وقيادة”.
ربما يكون خروج برلين عن ما يقرب من ثمانية عقود من ضبط النفس بعد الحرب هو المثال الأكثر واقعية لظاهرة مرئية في جميع أنحاء أوروبا وعبر المحيط الأطلسي. بعد سنوات عديدة قضاها في التفكير في انحداره وانحلاله ، اكتشف الغرب شيئًا مثل الكبرياء والهدف. على الرغم من كل عيوبها العديدة وإخفاقاتها الموثقة جيدًا ، فقد تم تذكيرها بأن علامتها التجارية من الحرية والديمقراطية أفضل من البديل: الاستبداد والقمع الذي يمارسه بوتين ، سواء في شكل قنابل تمطر على المدنيين الأوكرانيين أو الكمامات. عبر الأفواه وعصب العينينمن المواطنين الروس. على مدى الأيام العشرة الماضية ، أُعطي أولئك الذين اعتقدوا أن الناتو كان مفارقة تاريخية في الحرب الباردة ، دورة تنشيطية في سبب اختراعه وسبب ضرورته: حماية الدول الحرة من معتد جبار.
الشيء نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي. جاء البريطانيون ، على وجه الخصوص ، لربط الاتحاد الأوروبي بالتجارة في أحسن الأحوال ، وبيروقراطية مقلقة في أسوأ الأحوال. عندما فاز الاتحاد الأوروبي بجائزة نوبل للسلام في عام 2012 ، خدش الكثيرون رؤوسهم بعدم الفهم. حسنًا ، ليس هناك أي عذر للارتباك الآن. لقد استعان بوتين بذكرياتنا بأن الاتحاد الأوروبي قد تأسس على أساس الاقتناع بأن المستقبل الوحيد لقارة كانت في قلب حربين عالميتين خلال 30 عامًا كان أن تتضافر معًا: تقاسم السيادة بدلاً من القتل من أجلها. مشهد فولوديمير زيلينسكي يرتدي ملابس كاكي وهو يوقع طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيحتى مع اقتراب القوات الروسية ، أظهر مرة أخرى أنه بالنسبة للأوروبيين ، كان الاتحاد الأوروبي دائمًا معنيًا بالسلامة والسلام. كم من العار أن نفكر في المتشككين في أوروبا الذين تظاهروا بأن الاتحاد الأوروبي هو نوع من المحتل الأجنبي ، مشيرين إليه على أنه “اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية”. كم من العار الاعتقاد بأن الإسهام البريطاني في هذا النموذج النبيل بعد الحرب كان التخلي عنه.
حتى الطريقة التي نفكر بها في التاريخ قد تغيرت خلال هذه الأيام القليلة الماضية. لطالما تم ازدراء أي تحليل يضع وزنا كبيرا على دور الأفراد: بدلا من ” نظرية الرجل العظيم“للتاريخ ، كان من المفترض أن يركز العلماء على القوى الأعمق غير الشخصية ، والتحولات التكتونية التي جعلت تصرفات هذا الإنسان أو ذاك ذات أهمية ثانوية. ومع ذلك ، يتفق معظمهم الآن على أن “روسيا” ليس لديها رغبة ملحة للاستيلاء على أوكرانيا. قلة من الروس العاديين يتشوقون لجلب الجحيم وألم القلب إلى جيرانهم المجاورين. هذه الحرب هي بدلا من ذلك نزوة رجل واحد ، ربما مجنون. على الرغم من كل الساعات التي أمضيتها والحبر المنسكب في تحليل الجغرافيا السياسية لروسيا ومنطقتها ، فإن ما ينجم عنه هو توق بوتين للسلطة ومكان في التاريخ ، يجب تذكره جنبًا إلى جنب مع بطرس الأكبر. بسبب شخص واحد وحاجته النفسية الغريبة ، أصبح مليون شخص بالفعل لاجئين ومدن بأكملها تحترق من الأنقاض.
يقف ضده رجل ألهم أمته ونال إعجاب العالم. ربما كانت أوكرانيا ستظل صامدة بغض النظر عمن تولى منصب رئيسها. ربما كان من الممكن أن يثير تعاطف العالم حتى بدون وجود خبير في التواصل في كييف ، والذي عبر في سلسلة من الخطب القصيرة والصريحة عن مبدأ أساسي: أن لجميع الدول الحق في تحديد من هم وتحديد مصيرهم.
ربما. لكن وجود زيلينسكي ، ورفضه إنقاذ جلده أو وضع نفسه أولاً – ” أحتاج إلى الذخيرة ، وليس الركوب ” – لم يؤد فقط إلى تحفيز شعبه. لقد أعطى وضوحًا أخلاقيًا لهذه اللحظة. في عصر غير بطولي ، أصبح بطلاً عالميًا ، ومع رغبة بوتين على ما يبدو في لعب دوره كشرير شرير كرتوني ، فقد أدى ذلك إلى إضفاء البساطة على هذا الصراع ، والتي من السهل اعتبارها مبسطة ، لكنها تتمتع بقوة كبيرة على الرغم من ذلك.
لا شيء من هذا هو الراحة للعائلات في الأقبية ، للأطفال الذين ليس لديهم آباء. لا يفيدهم إذا كان التاريخ قد رفع وتيرته. مثل جميع ضحايا الحرب ، لا يريدون شيئًا أكثر من أن يتركهم التاريخ وشأنهم – ويتركهم يعيشون.
جوناثان فريدلاند كاتب عمود في صحيفة الغارديان
الجارديان
——————————
لن يستفيد بوتين من تجربته في سورية/ غازي دحمان
تشكّل أوكرانيا هاجساً جيوسياسياً خطيراً بالنسبة لصانع القرار في روسيا، نتيجة التداخل الجغرافي والديمغرافي والثقافي بين البلدين. ومن الناحية الدفاعية، تبدو أوكرانيا خاصرة رخوة لروسيا، فهذه البلاد، التي تغلب على تضاريسها السهول، شكلت، في مراحل تاريخية، ممرّاً للقوات الغازية لروسيا. وبالتالي، لا بد أن تنطلق أي قراءة عقلانية للأحداث الحالية من هذه الحقائق الصلبة.
لكن على الرغم من هذه الأهمية للمجال الأوكراني وحيويته لروسيا، لم تكن هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحدُث بهذه الجرأة، لولا التجربة العسكرية الروسية في سورية، والتي شكّلت دافعاً قويا لصانع القرار الروسي، بدعم من قادته العسكريين، إلى السعي إلى قضم أوكرانيا، لسببين مهمين:
الأول، تقدير النخب العسكرية الروسية أن النجاح في سورية يؤهل روسيا للقيام بعمليات مشابهة، ذلك أن العمل في سورية لم يكن سهلاً في بيئة محلية ودولية معادية، ووجود عشرات آلاف المقاتلين المنضوين في فصائل المعارضة والتنظيمات الإسلامية المتطرّفة (داعش وجبهة النصرة)، ووجود قوات أميركية وتركية، ودعم خليجي (كان موجوداً في عام 2015). وعلى الرغم من ذلك، استطاعت القوا ت الروسية تفكيك هذه المخاطر، وتحويل الأزمة السورية إلى فرصة، بفضل التكتيكات العسكرية المستخدمة، ونشاط الدبلوماسية الروسية.
الثاني، تحوّل روسيا إلى لاعب مهم في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط يدفعها إلى عدم التهاون مع محاولات تهميشها في أوروبا. من شأن هذا الأمر إلغاء المكاسب الجيوسياسية المتحققّة في سورية التي ترغب روسيا البناء عليها وتحقيق مزيد من المكاسب.
وفي سورية، جرّبت روسيا أصنافا عديدة من الأسلحة، وأشركت العدد الأكبر من قواتها العاملة في الحرب، وفي مختلف التخصّصات، كما اختبرت تكتيكات عسكرية عديدة حقّقت نجاحاتٍ مهمة وبتكاليف منخفضة. ويطمح القادة العسكريون الروس إلى تحقيق النتائج نفسها في أوكرانيا عبر استنساخ التجربة السورية، لكن الأمر لا يبدو ممكناً لأسباب عديدة:
العامل الجغرافي: تساوي مساحة أوكرانيا أكثر من ثلاث أضعاف مساحة سورية. وليس سرّاً أن أحد التكتيكات التي استخدمتها روسيا في سورية اعتمد على تقطيع المناطق، واختراع “خفض التصعيد” الذي ساعد روسيا في تفكيك قوّة المعارضة وقضم المناطق الواحدة تلو الأخرى، وقد استمرّت العملية الروسية من خريف 2015 حتى صيف 2018 “تسويات درعا”، أي بحدود ثلاث سنوات.
هذه المساحة الجغرافية الكبيرة لأوكرانيا ستُحدث مشكلات لوجستية قاتلة للجيش الروسي، حيث بإمكان المقاومة الأوكرانية قطع طرق الإمداد وإضعاف الحركة الروسية، سواء في مرحلة الهجوم الحالية، أو حتى في حال استطاعت روسيا استكمال عملية السيطرة، إذ من غير المرجّح استطاعة روسيا تحقيق احتلال مستقر. وعلى الرغم من وجود طرق برّية إلى أوكرانيا من روسيا وبيلاروسيا، إلا أن حمايتها على مسافات طويلة تحتاج أعدادا ضخمة من الجيش الروسي، يصعب توفيرها في ظل حرب عسكرية مشتعلة.
العامل الديموغرافي: يبلغ عدد سكان أوكرانيا ضعف عدد سكان سورية، وعندما دخلت روسيا إلى سورية، بعد أربع سنوات من الحرب، كان حوالي نصف سكانها قد نزحوا بسبب حرب الإبادة التي شنها نظام الأسد وأذرع إيران، في حين أن أكثر التقديرات تشاؤماً بالنسبة لأوكرانيا تتوقع نزوح ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين، وسيكون أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، ويشكل هذا العدد خزاناً بشرياً للمقاومة الأوكرانية في ظل تنامي الشعور القومي في البلاد.
عامل الدعم التسليحي: تلقّت أوكرانيا، حتى اللحظة، دعماً تسليحياً هائلاً، اشتمل على أنواع من الأسلحة ذات فعالية عالية في مواجهة الجيوش الغازية، وتمثل في بعضها أحدث نتاجات صناعات السلاح الأوروبية والأميركية، وخصوصا الصواريخ المضادّة للدروع والطائرات (الحوّامات) وأنواع من الطائرات المسيّرة، وهذا لم يدخل في خبرة التجربة الروسية في سورية، حيث إن أغلب الدعم كان على شكل رواتب، وضاع قسم كبير من الأموال بين السماسرة والمستفيدين، كما منعت أميركا وصول أنواع من الأسلحة لفصائل المعارضة، وخصوصا مضادّات الطائرات، وحتى مضادّات الدروع كانت تصل إلى المعارضة بالتقسيط وبأعداد قليلة.
وثمّة فارق آخر يتمثل بانقسام فصائل المعارضة بين الأطراف الداعمة، تركيا وأميركا، وخضوعها للأهداف السياسية والاستراتيجية لهذه الأطراف، وهذا أمرٌ من غير المرجّح حصوله في أوكرانيا بسبب وجود قيادة موحدة وحلفاء موحدين.
العامل الجيوسياسي: في التجربة السورية، لم يمثل العامل الجيوسياسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى موقع سورية في الإدراك الاستراتيجي الغربي. أما أوكرانيا فالوضع مختلف، إذ ثمّة اعتقاد أن نصر روسيا فيها سيغير المعادلات الجيوسياسية في العالم، ما سيؤدّي إلى تغيرات في بنية النظام الدولي وهيكلته. لذا، لن يسمح الغرب لروسيا بتحقيق نتائج مهمة، بل يجد نفسه أمام فرصةٍ لاستنزافها، والتخلص إلى الأبد من طموحات بوتين.
لن تستفيد روسيا في حربها الأوكرانية من التجربة السورية، بل ستكون لاحتمال اعتماد التكتيكات نفسها نتائج سلبية جداً، لكن المؤكد أن أوكرانيا، ومن خلفها أوروبا، تدفع ثمن انتهازية أميركا وسماحها لبوتين باستباحة سورية. وكما يقال، كانت الحرب العالمية الثانية امتدادا للحرب الأولى، فإن حرب أوكرانيا امتداد للحرب السورية، وقد تكلّف العالم أثماناً باهظة.
العربي الجديد
——————————
ارتدادات غزو أوكرانيا على سورية: أطراف النفوذ بين 3 ضفاف
تباينت مواقف أطراف النفوذ في سورية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تدخل السبت يومها العاشر على الكثير من التطورات العسكرية والسياسية.
ومنذ اليوم الأول للحرب الروسية نشر النظام السوري سلسلة بيانات أبدى فيها موقفه، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة السورية، ومسؤولي “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في شرقي البلاد.
وفي الوقت الذي تضاربت فيه مواقف كل من النظام السوري والمعارضة، أبدى بيان لـ”مسد” نشر أمس الجمعة حالة من “الحياد”، وهو الجهة السياسية التي تتلقى دعماً من الولايات المتحدة الأمريكية، منذ سنوات طويلة.
ماذا قال النظام؟
ومع تصاعد القتال في أول يومين من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا نشرت “رئاسة الجمهورية السورية” بياناً على لسان رأس النظام، بشار الأسد، واعتبر فيه أن ما يحصل هو “تصحيح للتاريخ”، مبدياً دعمه اللامحدود لما أقدم عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال الأسد في بيان “رئاسة الجمهورية” إن “ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم، الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”.
من جانبها اعتبرت مستشارته، بثينة شعبان، في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، الاثنين الماضي، أن “الغرب لم يلتزم بتعهداته حول توسع الناتو شرقاً، ولم يكن لدى روسيا خيار آخر”.
وكذلك الأمر بالنسبة لمستشارته الخاصة، لونا الشبل، والتي قالت لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مطلع الأسبوع الماضي، إن “الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها”، معلنةً أن “دمشق مستعدة للمساعدة في تخفيف العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا”.
الرئيس الأسد يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودار الحديث خلال الاتصال حول الوضع في أوكرانيا، والعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا الاتحادية لحماية السكان المدنيين في منطقة دونباس. pic.twitter.com/XTtDK1Yrv3
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) February 25, 2022
“موقف مضاد للمعارضة”
على الطرف المقابل كان هناك موقف مضاد للمعارضة السورية، والمتمثلة بـ”الائتلاف الوطني السوري”.
ونشر “الائتلاف” بياناً، قبل أيام، قال فيه إن “الشعب السوري يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي الوحشي، وإن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل سورية، وبذلك لا يمكن اعتبار تصويته لصالح الغزو الروسي في الأمم المتحدة يمثل سورية، بل يمثل من يتبع له وهو بوتين”.
وذكر رئيس الجسم السياسي المعارض، سالم المسلط عبر “تويتر”، الجمعة، أنه “من الأخطاء الجسيمة عدم طرد نظام الأسد الذي ارتكب أبشع المجازر من المنظمة الدولية حتى الآن”.
من جهتها نشرت “الحكومة السورية المؤقتة” بياناً، الأسبوع الماضي، وبينما دعمت أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وجهت دعوات للدول الغربية وأمريكا بضرورة دعم فصائل المعارضة في سورية بالأسلحة اللازمة لـ”مواجهة الاحتلال الروسي”.
الشعب السوري يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي الوحشي، ونظام الأسد غير شرعي ولا يمثل سورية، ولا يمكن اعتبار تصويته لصالح الغزو الروسي في الأمم المتحدة يمثل سورية، بل يمثل من يتبع له وهو بوتين.
من الأخطاء الجسيمة عدم طرد نظام الأسد الذي ارتكب أبشع المجازر من المنظمة الدولية حتى الآن.
— سالم المسلط – Salem Al-Meslet (@pofsoc) March 3, 2022
“مسد على الحياد”
وإلى جانب الموقفين السابقين بدا لافتاً، خلال الأيام التسعة الماضية حالة التريث التي أبداها “مجلس سوريا الديمقراطية” للتعليق عما يحصل في أوكرانيا.
وهذا المجلس يعتبر الذراع السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سورية، وتتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر بياناً، الجمعة، جاء فيه أن “الجنوح للحوار والتفاوض هو السبيل الأسلم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن الخيارات العسكرية أثبتت فشلها في حل الصراعات والأزمات الدولية والمحلية”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس الرئاسي” لـ”مسد” عقد اجتماعاً، في اليومين الماضيين، حيث بحث “مستجدات مسار التسوية في سورية، والجهود المبذولة لحل الأزمة، وانعكاسات الحرب في أوكرانيا على الحالة السورية التي تقف على أعتاب العام الثاني عشر منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011”.
واتفق المجتمعون على “ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية والمطالب المحقة للشعب السوري الذي خرج من أجلها عام 2011، وتحقيق التغيير الديمقراطي وإنهاء منظومة الاستبداد”، بحسب ذكر البيان.
عقد «المجلس الرئاسي» لـ #مجلس_سوريا_الديمقراطية، الخميس 3 آذار/مارس، اجتماعه الدوري في مدينة #الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لبحث التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على #الأزمة_السورية.https://t.co/KyNOJnPhZ6
— مجلس سوريا الديمقراطية (@SDCPressT) March 4, 2022
———————————
سلاح نوعي للمعارضة على طريق إسقاط الأسد/ عمر قدور
يوم الخميس الفائت عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن قلقه من أن يكون الأسوأ قادماً في أوكرانيا، ومن أن تلجأ القوات الروسية إلى تكتيك حصار المدن، واستطرد موضِّحاً في تصريحه لقناة فرانس2 بالقول: تذكروا حلب.. غروزني. هذا واحد من أقوال تُشجع على المقارنة الرائجة بين أوكرانيا وسوريا، وتُشجع من يتربص بالغرب على الاستدلال بأن مسؤوليه يعرفون جيداً جرائم الحرب المرتكبة في غروزني وحلب، لكنهم الآن قلقون حصراً لأن المتضرر شعب أوروبي آخر؛ لأن الضحية الآن شقراء بعيون زرق.
من جهة مقابلة، وقد زالت المخاوف من تهدئة روسية-غربية تسبق غزو أوكرانيا يقبض بوتين ثمنها في سوريا، لن يكون مستغرباً أن ينعقد بعض الآمال على تفاقم المواجهة الغربية-الروسية، وأن تنال الساحة السورية حصة منها. الحجة في هذا الرأي أن الغرب أدرك عواقب تساهله مع بوتين في سوريا، وسيسترد منه الهدية التي سبق أن منحه إياها، والساحة السورية مهيأة لإيقاع الخسائر به، الأمر يتوقف فقط على قرار أمريكي بفتح صنبور الأسلحة النوعية على غرار ما فُتحت في اتجاه أوكرانيا، أو حتى أقل من ذلك.
لنقل أنه حلم ليلة صيف. ثم لا بأس في المضي معه حتى النهاية، فليس من المحتم أن تكون المقارنة بين سوريا وأوكرانيا نوعاً من الثرثرة ومضيعة للوقت، بل يمكن أن تكون كاشفة أيضاً. تبرز وجاهة هذا الاستخدام من الاستخدام الآخر الذي يريدها كاشفة لنفاق الغرب وعنصريته، وقد رأينا كيف انتعش مع تصريحات ليست بالجديدة من اليمين المتطرف الغربي تفرّق بين اللاجئين بحسب لون البشرة والعيون، لتُبنى عليها مغالطات كأننا لم نكن شهوداً على الأمس القريب الذي فيه ما يكذّب هذا التظلم وفيه ما يدعمه.
إذاً، لنقل: وصلت مئات أو آلاف صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، ووصل عدد أضخم من مضادات الدروع إلى “فصائل المعارضة”، وأعطى الغرب إيعاز الهجوم: إلى الأمام! أول العثرات التي سيصادفها هذا السيناريو الوردي وجود فصائل غير راضية عن حصتها من السلاح النوعي الجديد، ما قد يشجّعها على استخدام حصتها منه بالهجوم على مستودعات فصائل نالت كمية أكبر كي تصحح أخطاء الغرب في توزيع الأسلحة. أما الفصائل المصنّفة إرهابية ومحرومة من الإمدادات فستسارع إلى مهاجمة نظيراتها اللواتي حصلن على الإمداد قبل التدرب جيداً عليه. لا يُستبعد من بين قيادات الثانية وجود من هو متلهف للحصول على الثروة، ومستعد لبيع الأسلحة التي هبطت عليه كأنها هدية من السماء.
في الزحف في اتجاه دمشق ستنشب حروب بينية أخرى، فهناك السباق المحموم من أجل الوصول أولاً والحصول على حصة أكبر من كعكة السلطة، وهذا يستدعي ضرب فصائل منافسة لإعاقتها عن التقدم، ولا بأس في استخدام السلاح النوعي الجديد. على الطريق نفسه، هناك مكاسب أخرى قبل الوصول إلى الجائزة الكبرى؛ ثمة مناطق استراتيجية عسكرياً، وثمة مناطق للثروات الطبيعية، وأيضاً السدود.. محطات الكهرباء.. محطات المياه، وكلها أهداف للتقاتل بين فصائل صار لديها فائض من السلاح، ولها مطامع تتعلق بما بعد إسقاط الأسد.
لا يفيد مع التصور السابق تخيّلُ وجود قيادة موحدة، فأمراء الحرب لن يتوحدوا، وإذا فُرض عليهم خارجياً التوحيد لا يُستبعد حدوث انشقاقات تُستخدم فيه الأسلحة النوعية مع أول اختبار لوحدتهم. قد يكون الحل في أن يأتمروا جميعاً بقيادة خارجية عليا، على النحو المعمول به الآن تحت إمرة أنقرة، لكنه حل يمنح أنقرة قدرة غير محدودة على تقرير ما سيكون عليه الحال بعد إسقاط الأسد، الأمر الذي لن يكون مقبولاً دولياً ومن نسبة لا يُستهان بها من السوريين، حتى إذا استثنينا الأكراد، وإذا استثنينا فرضية استخدام الفصائل التابعة لأنقرة الأسلحةَ النوعية ضدهم أولاً بما أنهم في صدارة هواجس أنقرة الأمنية.
لقد رأينا خلال سنوات إصراراً أمريكياً على عدم تكرار السيناريو العراقي، وتحديداً على عدم التدخل الأمريكي المباشر ورعاية فصائل تُقدِم على إسقاط الأسد. وقد سبق لإدارة بوش بالتنسيق مع لندن أن جمعت شراذم المعارضة العراقية، ثم رأت اقتتال المعارضين للاستحواذ على تركة صدام من السلطة والثروة. المثال الأفغاني الطازج، وإعلان إدارة بايدن تخلي واشنطن عن نشر الديموقراطية يضع الموقف من القضية السورية ضمن سياق، أي أنها ليست استثناء كما يحلو للبعض تصوير المظلومية السورية.
وكي لا يبدو السيناريو وليد السنوات الأخيرة، رأى السوريون تقاتل فصائل في الغوطة “على مشارف دمشق” قبل وبعد إحكام قوات الأسد محاصرتها، وهناك فصائل كبرى غنمت مستودعات ضخمة من السلاح الذي استُخدم ضد فصائل أخرى أكثر مما استُخدم ضد قوات الأسد. رأينا فصائل مهيمنة تستهتر بالمطلب الأساسي للثورة وهو الديموقراطية، وكان الغرب “الخبيث” ذاته متساهلاً معها بتصنيفها على الفصائل المعتدلة.
في تلك السنوات الأولى على اندلاع الثورة، قدّم الغرب دعماً سخياً لجمعيات وأفراد سوريين، ورأى مثلما رأى السوريون مصير مساعداته. هنا يحضر الاستثناء السوري، فيُلام الغرب والخليج على مصير المساعدات المقدَّمة، ويروج الكلام عن مقاصد خبيثة وراءها، من قبيل أن غايتها إفساد المعارضة والثورة أو شراء الذمم، أو أنها أصلاً ذهبت إلى جيوب مرتزقة. وهكذا يُشيطن الخارج بدل محاسبة المعارضين الذين أساؤوا استخدام الدعم، وبدل إقصائهم لئلا يكونوا وسيلة الخارج المزعومة في النيل من الثورة. إنها عبقرية المطالبة بالدعم الخارجي ثم اعتباره من أسباب الهزيمة، عبقرية اتهام الخارج بتصنيع معارضة على قياس توجهاته وعدم فعل أي شيء لإسقاطها.
إذا كانت نسبة غالبة من معارضي الأسد غير راضية إطلاقاً عن هياكل المعارضة السياسية، وغير راضية عن الفصائل التي صارت تُعرف بانتهاكاتها أكثر مما تُعرف بأدائها ما يُفترض أنها أنشئت لأجله، فمن السذاجة “على الأقل” انتظار أن يرى الغرب الهياكل ذاتها بعين الرضا. هذا وجه من وجوه النفاق السوري لا الغربي، يريد أصحابه من العالم دعمَ ما لا ينال قبول أصحاب الشأن أولاً، ويريد من الغرب التحرك بفعالية بينما أصحاب القضية متفرغون لعقد المقارنات التي تعزز شعورهم بالنقمة عليه.
إذ تحضر المقارنة بين سوريا وأوكرانيا، جائزة كانت أم قسرية، فإن ما يستكمل الأصوات العنصرية في الغرب هم هؤلاء الذين يستغلونها ويتناسون تماماً أن الغرب لم يكن على قدر تطلعاتهم، لكنه اليوم أيضاً ليس على قدر تطلعات الأوكرانيين في مواجهة الاحتلال الروسي. ربما لحسن الحظ أن أولئك العنصريين لا يعرفون ما نعرفه عن واقع أحوالنا، أي كل تلك الأخطاء والخطايا التي ينبغي الاعتراف بها، وتقديم بديل عنها يقنع السوريين بدل التلطي وراء مظلومية البشرة السمراء.
المدن
————————————-
الربط بين سوريا وأوكرانيا سياسياً/ رضوان زيادة
عندما تقوم بالبحث على محرك البحث غوغل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسوف تجد كمّاً هائلا من التحليلات يقارن بينه وبين ستالين، ويتوقع أن بوتين لن يكتفي بأوكرانيا وإنما سيتجه غربا باتجاه بولندا وربما رومانيا، مستكملا مسيرته في أوروبا تماما كما فعل هتلر بالعبور إلى بولندا في أول دولة يقوم بغزوها في الطريق نحو السيطرة على كامل أوروبا.
التشابه بين هتلر وستالين وبوتين ليس بعيدا أو كبيرا، فكل الدكتاتوريين عبر العالم يتصفون بصفات شخصية شبيهة وخاصة إذا تولدت عندهم نوازع السيطرة على أكبر حجم ممكن من الأراضي، ولذلك فغزو أوكرانيا لم يكن مبررا لأي من المعايير العقلية أو القانونية سوى أن شخصا مريضا في الكرملين قرر أن يستخدم جيشه الجرار في احتلال بلد جار له واتهام قيادتها بأنهم “نازيون” أو “فاشيون” إلى غير ذلك من الأوصاف التي يكررها بوتين في إعلامه، ومن المستحيل على أحد تصديقها خاصة إذا عرفنا أن والد الرئيس الأوكراني الحالي زيلنسكي قاتل مع الجيش الروسي ضد النازية في الأربعينيات من القرن الماضي.
بوتين الذي له سوابق في التدخل عسكريا في جورجيا والسيطرة على بعض الأقاليم الأوكرانية وخاصة شبه جزيرة القرم، وفي التدخل في سوريا للسيطرة على مقدراتها بفضل الأسد الذي سلم روسيا كل الموارد والثروات السورية من أجل حمايته وحماية مقاره، لذلك يمكن القول إن هناك علاقة مباشرة بين ما يجري في أوكرانيا اليوم وبين ما يجري في سوريا، ووضع سوريا اليوم يعتمد على رد الفعل الغربي الأوروبي والأميركي على الغزو الروسي وعلى المقاومة الأوكرانية، فإذا كان ردا قويا وكانت هناك مقاومة للغزو فهذا سيضعف روسيا، واعتقد أن روسيا ضعيفة في أوكرانيا ما سيجعلها ضعيفة أيضا في سوريا ويجبرها على التخلي عن قواعدها العسكرية هناك ودعمها الاقتصادي والعسكري للأسد.
ربما لن يكون هناك ربط مباشر بنظر الغرب اليوم بين ما يجري في أوكرانيا وسوريا لكون التركيز السياسي الأكبر سيبقى فقط مركزا على أوكرانيا، كما أستبعد أن يكون هناك أي تغيير جوهري في الوقت الحالي ربما تركيز إعلامي فقط على جرائم روسيا في سوريا من أجل إحراجها أكثر، ويجب أن لا يكون هناك أية توقعات بأن تقوم الولايات المتحدة بتزويد المعارضة بأسلحة نوعية، فهذا الأمر ليس مطروحا أبدا الآن ولا اعتقد أن أميركا لديها رغبة في إعادة فتح ملف التسليح في سوريا حيث إنها تعتبر وقف تصعيد العنف هناك أفضل الحلول الممكنة بعد صعوبة الوصول إلى حل سياسي عبر تطبيق القرار ٢٢٥٤.
لكن بنفس الوقت هناك مسؤولية تقع على المعارضة السورية من أجل إعادة بناء استراتيجية جديدة من أجل بناء أولويات للملف السوري على الأجندة الدولية.
فالملف السوري أصبح معقداً ومتشعباً للغاية فاختلطت به قضايا معلقة كثيرة التعقيد أيضا كاللاجئين والتدخلات الإقليمية والإرهاب وغيرها، كل ذلك مما يدفع أي دولة بما فيها أميركا للتردد في اتخاذ أي موقف أو التصدي لحل هذه القضية لأنها ستتحمل كل تبعاتها، وبالتالي قرر الرئيس بايدن متابعة سياسة سلفه في عدم الانخراط في القضية السورية والتركيز فقط على تفصيل صغير يتعلق بضمان المساعدات الإنسانية، والقضاء على داعش ومن الجو حصراً والاعتماد على حلفاء محليين على الأرض من أجل تنفيذ هذه المهمة، وبالتالي انخراط أي رئيس أميركي جديد سياسياً كان مستحيلاً إلا إذا وجد دافعا شخصيا له للاهتمام ووضع سوريا في لب أولوياته.
صحيح أن الرئيس بايدن لديه خبرة في السياسة الخارجية أو الخيارات العسكرية لكنه يشعر أن تركيزه الأكبر يجب أن يكون على الوضع الداخلي الأميركي وخاصة ضمان تعافي الاقتصاد الأميركي بعد كورونا.
من كل ذلك، أتوقع أن إدارة الرئيس بايدن تعمل على تطوير استراتيجية سياسية وعسكرية بحق سوريا بعد ما جرى في أوكرانيا ربما تعتمد في بعض عناصرها على تطوير أولوية الدفع بالانتقال السياسي وإزاحة الأسد.
المشكلة الرئيسية في هذه الاستراتيجية ستكون المعارضة السورية السياسية منها والعسكرية، وإعادة تموقع القوى الإقليمية، فالمعارضة السورية السياسية في انهيار تام بفعل خلافات داخلية والأهم عدم قدرتها على التأثير في مجرى الأحداث في سوريا بفعل عنف النظام الأعمى مما ألغى أي معنى لمفاوضات أو عملية سياسية يمكن لها أن تسهم في بناء معارضة سياسية ذات تأثير وفعالية، أما المسلحة منها فقد انهار الجيش السوري الحر كقيادة مركزية في عام 2014 ولم تفلح أية جهود في إعادة توحيد الفصائل المختلفة تحت راية واحدة، ومع تعدد الفصائل وتفرقها واتخاذها مسميات عدة، لم تفلح في تكوين بديل عسكري ومع تلاحق سلسلة الانهيارات العسكرية وآخرها في حلب، أدركت الفصائل العسكرية أنها تعيش مرحلة من التراجع والانهيار مع تزايد دعم الميليشيات الإيرانية وحزب الله لنظام الأسد على الأرض، وهو للأسف ما لم يدفع هذه الفصائل إلى القيام بإعادة بناء التحالفات العسكرية وتركيز جهودها في استراتيجية عسكرية موحدة، الذي حصل هو العكس تماما حيث انهارت واختفت هذه الفصائل رويداً رويدأ.
أما على المستوى الإقليمي فكان تغير الأولويات عاملاً رئيسياً في انهيار المعارضة السورية المسلحة خاصة بالنسبة لتركيا والسعودية، فتركيا أصبح تركيزها على منع الكرد المتحالفين مع حزب العمال الكردستاني من كسب المزيد من الأراضي السورية، والسعودية مع سيطرة الحوثيين على اليمن أصبحت الحديقة الخلفية لها أولوية لا بد من تنظيفها، ولذلك يمكن القول إن نقطة الضعف الرئيسية في الاستراتيجية الأميركية ستكون المعارضة نفسها التي تركت لسنوات كي تحارب وحدها قوات نظام الأسد وحزب الله والميليشيات العراقية والإيرانية وقوات الحرس الثوري وفوق ذلك كله القوات الروسية التي تدخلت جويا مع نهاية عام 2015 وبريا مع نهاية عام 2016.
لذلك ولإنجاح أية استراتيجية أميركية في سوريا للتخلص من نظام الأسد يجب أن تعيد المعارضة السياسية والعسكرية إعادة تمركزها وتنظيم صفوفها وإلا أضاعت الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من سوريا.
تلفزيون سوريا
——————————
كييف تناشد الناتو:لا تسمحوا لبوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا
دعا وزير الخارجية الأوكرانية دمترو كوليبا الجمعة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ألا يسمحوا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا.
وقال كوليبا خلال مشاركته في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية حلف الناتو الجمعة إن بلاده “ستواصل القتال وهي مستعدة للقتال”، مشيراً في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى شركاء لمساعدتهم عبر إجراءات “حازمة وسريعة”، مضيفاً “تصرفوا الآن قبل فوات الأوان..لا تدعوا بوتين يحوّل أوكرانيا إلى سوريا”.
وجاءت تصريحات كوليبا بالتزامن مع اجتماع دول شمال الأطلسي في مقر الناتو في بروكسل. وأكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي.
وأضاف ستولتنبرغ أن “الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية”.
وتزامنت تصريحات الوزير الاوكراني حول سوريا مع تصريحات الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول “انتهاكات الجيش الروسي في أوكرانيا وسوريا والشيشان”.
وقالت كالامار في مقابلة مع موقع “ميديابارت” الفرنسي إن “التدخلات العسكرية الروسية بالتاريخ الحديث، سواء كان ذلك في الصراع بدونباس أو سوريا أو في سياق حملاتها العسكرية داخل البلاد في الشيشان، يشوبها تجاهل صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت أن “الجيش الروسي داس مراراً وتكراراً على القانون الإنساني الدولي من خلال إخفاقه في حماية السكان المدنيين، بل إنه نفذ هجمات استهدفت المدنيين عن عمد”.
وتابعت: “في ذروة النزاع المسلح في دونباس تم استخدام الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة بشكل ملحوظ في المناطق المكتظة بالسكان وفي المنازل، ليفر أكثر من مليون شخص من القتال ويموت أكثر من 13 ألفاً، مما مزق المجتمعات وشتتها وضيع حقوق السكان المدنيين مع الإفلات من العقاب”.
وأردفت “وفي سوريا عام 2015، تم توثيق سلسلة غارات جوية روسية على مناطق سكنية في حمص وإدلب وحلب، خلفت ما لا يقل عن 200 قتيل مدني. وعام 2020، استهدفت الطائرات الروسية المدارس والمستشفيات، رغم أنها كانت مدرجة أحياناً على قائمة الأمم المتحدة للمواقع المحمية”.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي الخميس جمع الأدلة حول “جرائم الحرب والإبادة الجماعية” في أوكرانيا، بعد تلقيها طلبات من 39 دولة بإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي.
وفي السياق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، قراراً بإرسال بعثة تقصي حقائق في ما يخص جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
وصوّت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعداً لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية. ولم تصوّت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.
وامتنعت باقي الدول الأعضاء عن التصويت بما فيها الدول الداعمة تقليدياً لموسكو: الصين وفنزويلا وكوبا. وقال مندوب أوكرانيا: “أشكر جميع من صوّتوا لصالح القضية المحقّة”.
وتنفي روسيا مراراً استهدافها المدنيين أو المواقع المدنية في هجومها على أوكرانيا وتقول إن الهجوم هدفه “حماية إقليم دونباس” وتتهم بدورها القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين دروعاً بشرية ونصب صواريخ بين الأحياء السكنية.
——————————-
الغارديان: روسيا اعتمدت تكتيكها في سوريا لتدمير مدن أوكرانيّة
أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً سلطت فيه الضوء على الدمار الذي لحق بمدنٍ وبلدات أوكرانية، في مقارنة مع الأسلوب الوحشي الذي اتبعته القوات الروسية في تدميرها المدن السورية، وخصوصاً في حلب.
وركّز التقرير على بلدتي شاستيا وفولنوفاكيا شرقي أوكرانيا، اللتين تعرضتا لقصف عنيف منذ الساعات الأولى للغزو الروسي كونها تجاور منطقتي لوغانسك ودونيستك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.
وبالرغم من أن الضربات استهدفت المنازل والمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء أوكرانيا، إلا أن سكان بلدة شاستيا الصغيرة وفولنوفاكيا المجاورة يقولون إن القصف والهجمات الصاروخية والغارات الجوية منذ بداية الحرب دمرت كل المباني تدميراً شاملاً لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر.
وفي حين رفع الروس علمهم فوق أنقاض شاستيا، يقول النائب المحلي في البلدة دميترو لوبينيتس إن الهجوم في فولنوفاكيا لا يزال شديدا لدرجة أن الجثث لم تُجمع بعد. ويضيف في اتصال هاتفي مع الصحيفة: “لا يزال الأوكرانيون شجعانا بما يكفي للقيام بمهام الإنقاذ، ويعودون فقط من أجل الأحياء”.
ويتعرض الآلاف من سكان فولنوفاكيا للحصار داخل الملاجئ، مع تناقص إمدادات الغذاء والماء، وهم يحتمون من هجوم “لا معنى له”، حيث إنه لا يوجد في وسط بلدتهم مدافعون عسكريون، كما أن خط التماس يبعد 20 كيلومتراً.
ظلّت بلدة شاستيا الصغيرة نسبياً خارج عناوين الأخبار منذ أن شنّت موسكو حربها الوحشية ضد المدنيين إلى أكبر مدن البلاد. ولكن في فولنوفاكا المجاورة، وصلت التكتيكات المنتهِكة للقانون الدولي لإرهاب المدنيين كأهداف عسكرية، والتي تم صقلها في سوريا، وفق الغارديان.
وبحسب النائب لوبينيتس، فإن “القصف لا يتوقف أبدا، كل خمس دقائق هناك قصف بقذائف الهاون أو قذائف مدفعية، وبعض المباني تعرضت للقصف بواسطة أنظمة صواريخ متعددة”.
ويضيف: “لا يوجد في المدينة أي مبنى لم يتعرض لأضرار مباشرة أو جانبية. لذلك تعرضت بعض المباني لدمار كبير، وبعضها دمر بالكامل وسوّي بالأرض”.
قبل الحرب، كان عدد سكان البلدة 25 ألف نسمة، يقول لوبينيتس، ويشير إلى أن 3 آلاف شخص على الأقل قد بقوا فيها وهم محاصرون الآن، وبينهم المئات من الأطفال.
ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين الذين أجلوا عائلاتهم من شاستيا أن 80- 90 في المئة من المدينة تضررت في قصف مكثف استمر أياما، وكما هو الحال في فولنوفاكيا، بالكاد لم تمس أي مبانٍ بالكامل.
وقال: “بدأ الناس في الإخلاء بعد ثلاثة أيام، عندما توقفت القوات الروسية عن قصف المدينة وتمكن الناس من مغادرة الملاجئ”. لم يكن لدى الناس ماء ولا غاز ولا كهرباء لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بسبب القصف. لقد استخدموا جميع أنواع أسلحتهم وصواريخ غراد والمدفعية والألغام”.
ويصف التقرير الدمار الذي لحق بالمدن الكبرى مثل تشيرنيهيف وخاركيف بأنه “قاتل ومروع”، لكنه لا يزال يؤثر على جزء صغير نسبيا من البلدات، حتى لو كان الرعب الذي يغرسه يلقي بظلاله على كل مدني ما زال محاصرا هناك.
لكن ما تظهره القوات الروسية على ما يبدو في هذه البلدات الصغيرة هو أنها مستعدة لترك وراءها أرضا قاحلة على نطاق واسع، كما فعلوا في غروزني في الشيشان، أو – جنبًا إلى جنب مع قوات النظام السوري- في مدينة حلب القديمة. حيث لم تمنعهم الإنسانية ولا التراث.
———————————
بـ”مزاعم التجنيد”.. روسيا والأسد يلعبان “الورقة السورية” في أوكرانيا
يتعقد الوضع في أوكرانيا شيئاً فشيئاً مع دخول الحرب الروسية يومها العاشر، وفي الوقت الذي لا تلوح فيه أي بوادر تهدئة اتجهت موسكو ونظام الأسد في الساعات الماضية للعب “الورقة السورية”.
وهذه الورقة كانت قد أقحمت أولاً في بيان للاستخبارات الروسية، أمس الجمعة، حيث زعمت أن “قاعدة التنف” في سورية باتت “معسكر تدريب لإرهابيين من داعش قبل إرسالهم إلى دونباس”.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة “تواصل تشكيل زمر جديدة من الإرهابيين في التنف، وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا”.
وعقب هذا البيان زعمت إذاعة “شام إف إم” المقربة من النظام السوري، اليوم السبت، أن فصائل “الجيش الوطني السوري” في شمال سورية “فتحت باب التسجيل للراغبين بالانتقال إلى أوكرانيا، وقتال القوات الروسية”.
وقالت الإذاعة المحلية التي تبث من دمشق: “الإقبال على التسجيل ما يزال في بدايته ومعظم المسلحين المسجلين يطمعون بالانتقال إلى أوكرانيا، لاتخاذها كموطئ قدم يمكنهم من الفرار لاحقاً إلى باقي دول أوروبا طلباً للجوء”.
ولم يصدر أي تعليق أمريكي حول المزاعم الروسية الخاصة بقاعدة “التنف”، فيما نفت مصادر عسكرية من شمالي سورية لـ”السورية.نت” التقارير التي تتحدث عن “قوائم للتسجيل”.
وتتلقى فصائل “الجيش الوطني” دعماً لوجستياً وعسكرياً من تركيا، وهي الدولة التي أعلنت مراراً، في الأيام الماضية، أنها ستبقى في موقف “المتوازن” ما بين موسكو وكييف.
وحتى الآن لم تتضح الغايات الروسية والصادرة عن نظام الأسد من الإعلان عن هكذا تقارير.
وسبق وأن أطلق مسؤولون روس تصريحات خلال السنوات الماضية بشأن “قاعدة التنف”، والتي تقع على المثلث الحدودي ما بين سورية والعراق والأردن.
وكشفت التصريحات عن حالة من التوجس والغضب الروسي، بشأن الدور الذي تلعبه القوات المتمركزة في القاعدة هناك، فيما ذهبت في منحى آخر للترويج لعمليات إجلاء النازحين السوريين المقيمين في مخيم الركبان، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري.
وبالتوزاي مع ما سبق ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط، السبت، أن “وسطاء” في العاصمة دمشق بدأوا توقيع عقود مع شبان سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن قوائم المرشحين الجدد تضم نحو 23 ألفاً من الشبان، الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الأسد، ضمن ميليشيات “جمعية البستان”، التي كانت تابعة لابن خال بشارالأسد رامي مخلوف، ومن ثم انتقلوا إلى ميليشيا “الدفاع الوطني”، التي يقال إنها مرتبطة بشكل كبير بإيران.
————————
الغزو الروسي لأوكرانيا.. الأزمة – التحديات والمآلات/ مهند الكاطع
يمكن أن نحدد سنة 2004 كبداية لظهور بوادر أزمة عدم الثقة بين روسيا وأوكرانيا، ففي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 وعلى خلفية ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت في أوكرانيا ثورة شعبية عارمة كان مركزها كييف ومناطق غرب أوكرانيا على خلفية ما تردد عن التزوير والفساد وترهيب الناخبين وسوء الأوضاع الاقتصادية، وبدا هذا الأمر جديدا على الأوكرانيين الموزعين بين الأقاليم الغربية الناقمة على روسيا والمتعجلة للاندماج مع وجهتها الجديدة أوروبا والتي أيدت مرشح الرئاسة التكنوقراط فيكتور يوشينكا صاحب الميول الغربية، مقابل الأقاليم الشرقية الأكثر وفاء لروسيا والتي تشترك وأهلها في اللغة وطريقة التفكير والتي كانت تنظر بعين الشك لهذا الحراك الذي كانت موسكو تتهم الغرب بأنه يقف وراءه.
بات ميدان التحرير في كييف رمزاً للثورة البرتقالية التي أصرت على إعادة فرز الأصوات، وطالبت بوقف التدخل الروسي في شؤون البلد، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على تحقيق آمال الشعب الأوكراني في الكرامة والتنمية. ومع الضغط الشعبي للثوار الأوكران جرى إعادة فرز الأصوات لتحقق الثورة البرتقالية جزءا من مكاسبها، عبر إعلان خسارة فيكتور يانوكوفيتش (المرشح الموالي لروسيا) في جولة الإعادة لصالح الرئيس فيكتور يوشينكو، بما يمكن أن نعتبره أول خسارة روسية في هذه المعركة السياسية أمام أوروبا والغرب على الأرض الأوكرانية في برتقالية 2004.
أطلق على الرئيس يوشينكا لقب “الشهيد الحي” للثورة البرتقالية، وذلك بعد أن كاد أن يقتل عندما دُسَّت له كمية من سم “الديوكسين” أثناء اندلاع الثورة وقبل فرز الأصوات، في حادثة وجهت فيها أصابع الاتهام للمخابرات الروسية المعروفة بولعها باستخدام السم في اغتيالاتها، ورغم نجاته بأعجوبة فقد أصيب بتشوهات جلدية في وجهه بقيت علامة فارقة ودافعاً إصرار أنصاره على إنجاح ثورتهم وتعميق الهوة مع روسيا.
الأزمة الثانية 2013-2014
في انتخابات عام 2010 استطاع فيكتور يانكوفيتش الموالي لروسيا الوصول للسلطة خلفاً لخصمة فيكتور يوشينكو الذي فشل في الوعود التي قدمها للشعب في تأمين الوظائف وخفض الضرائب وتحسين الأوضاع المعيشية ورفع الناتج الزراعي وتقليل الفجوة بين الأثرياء والفقراء عبر محاربة الفاسدين وخاصة أولئك المرتبطين بروسيا.
وقد تجددت مظاهر الاحتجاج ضدّ الرئيس الموالي لروسيا، على خلفية رفضه لتوقيع اتفاقيات شراكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 مع الاتحاد الأوروبي، وأغلق المحتجون المؤيدون للغرب وسط العاصمة كييف، وقوبلت احتجاجاتهم بالعنف الذي أدى إلى سقوط ضحايا منهم، الأمر الزي زاد في حدة المواجهات، التي انتهت بخلع الرئيس يانوكيفيتش وهروبه باتجاه روسيا، ليتسلم ألكساندر تورتشينوف الرئاسة بالوكالة لنحو 4 أشهر حتى بدء الانتخابات الرئاسية والتي أوصلت رجل الأعمال الثري بترو بوريشنكو المعروف بتأييده للغرب للسلطة بعد حصوله على 54% من أصوات الناخبين، شعرت موسكو بأن نفوذها في كييف بات مهدداً، فبدأت بدعم مجموعات تابعة لها في شرق البلاد الأوكرانية، ليتم تشكيل نواة الحركة الانفصالية في إقليم الدونباس، والذي بات يشكل مزيدا من الضغوط على حكومة أوكرانية الجديدة، خاصة بعد زيادة الضغوط عليها مع سوء العلاقات مع موسكو، التي بدأت بالشعور بتقلص نفوذها في كييف، وبدأت بتحريك أجواء النزاعات مع كييف عن طريق دعم الدعوات الانفصالية في شرق البلاد، مستغلة المظاهرات التي بدأها سكان جنوب وشرق أوكرانيا نتيجة استيائهم من السلطة الأوكرانية الجديدة، وشنت روسيا حملة سياسية وعسكرية منسقة ضد أوكرانيا، وقاد مواطنون روس الحركة الانفصالية مدعومين بمتطوعين وعتاد زودتهم بها روسيا، وبدأ صراع مسلح ما بين القوات الانفصالية التابعة لإقليمي دونيتسك ولوهانسك والحكومة الأوكرانية. أعقبت المظاهرات ضم الاتحاد الروسي للقرم.
الأزمة الثالثة 2021-2022
وصل الشاب فلاديمير زيلينسكي (تولد 1978) إلى السلطة في انتخابات مايو 2019 بعد أن حقق فوزا كاسحا (بنسبة 73,22%) على منافسه الرئيس بوريشنكو، وقد اتخذ الرئيس الجديد عدة خطوات في محاربة وعزل رؤوس الفساد، ربما ليس بالمستوى الذي ظهر فيه في آخر فيلم كوميدي قام بتمثيله، حينما لعب دور “مدرس التاريخ” الذي يترشح للرئاسة، ويفوز بثقة الشعب، ويحارب الفساد في البلاد ويبدأ حملته بإطلاق النار على نواب البرلمان جميعاً بوصفهم فاسدين، وهذا الفيلم ربما كان أحد أسباب الشعبية التي أوصلت زيلينسكي “الممثل الكوميدي” إلى السلطة.
لم يعرف العالم الكثير عن زيلينكسي الذي كان موضع تشكيك واتهام بعدم امتلاكه خبرات سياسية أو عسكرية سابقة، لكن مع بدء الأزمة مجدداً مع روسيا، ظهر زيلينكسي كقائد قريب من قلوب شعبه، ويعرف ماذا يريد بدقة، ويجيد لغة الضغوط على الحلفاء قبل الأعداء، الأمر الذي جعله يكتسب ثقة كبيرة على المستوى المحلي داخل أوكرانيا، وكذلك المستوى الدولي.
خلال أقل من سنتين من تسلمه السلطة استطاع زيلينكسي أن يوظف كل الوسائل الدبلوماسية لممارسة ضغوط على روسيا في مسألة شبه جزيرة القرم، وكذلك الأقاليم الانفصالية، وكان يظهر بين الفينة والأخرى بالزي العسكري على خطوط التماس مع الانفصاليين، ونجح في تدويل قضيته و تقوية علاقته مع الغرب بشكل كبير، واهتم في مسألة زيادة فرص تجارته الدولية، وتسليح الجيش، وعزز علاقته التجارية والعسكرية مع تركيا بتوقيع العديد من الاتفاقيات، كان أبرزها صفقة شراء طائرات بيرقدار المسيرة التي أثبتت كفاءة في معارك ناغورني قاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، والأكثر من ذلك نجح في إقناع تركيا بفتح مصنع لإنتاج مشترك من نسخ طائرة بيرقدار على الأراضي الأوكرانية، كل تلك التحركات للشاب الذي تم التقليل من قدراته، أغضبت الدب الروسي الذي بدأ يحرك وحداته العسكرية باتجاه الحدود مع إضمار نيته لغزو أوكرانيا.
الغزو الروسي فبراير / شباط 2022
أثارت حشود عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية في أبريل /نيسان 2021 مخاوف الغرب، وزادت تلك المخاوف مع ظهور حشود جديدة في أكتوبر / تشرين الأول 2022، أعقبت مناورات عسكرية مع بيلاروسيا، وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبا يعربون مراراً عن مخاوفهم من تلك الحشود ويطالبون روسيا بتفسيرات لها، بالمقابل كان الروس يقللون من شأن تلك المخاوف، مبررين بأنّ القانون الدولي يضمن لأي دولة نقل قواتها ضمن حدودها بالطريقة التي تراها مناسبة. لكنهم في نفس الوقت كانوا يشددون على التشكيك بسيادة أوكرانيا عبر ربطها بالتبعية للغرب.
الولايات المتحدة بدأت منذ شهر يناير/ كانون الثاني بالتحذير من غزو عسكري روسي، بل وتحدد ساعة الصفر له مستندة على معلومات استخباراتية، وكررت روسيا نفيها لتلك المزاعم واصفة إياها “بالهلع غير المبرر”. كذلك كانت السلطات الأوكرانية تميل للتصريح بعدم وجود مؤشرات للغزو في محاولة لتهدئة هلع السكان المدنيين.
في 21 شباط/فبراير 2022، ظهر بوتين بخطاب طويل يتحدث فيها عن مجريات الأزمة مع أوكرانيا، واختتم الخطاب بالاعتراف بـ «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أمرَ بوتين بإرسال القوات الروسية إلى دونباس، فيما وصفته روسيا «بمهمّة حفظ السلام».
في 22 شباط/فبراير 2022 صرح كل من الرئيس الأميركي والأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء الكندي ووزير الخارجية الأوكرانية كلّ على حدة: أنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا قد بدأ، سَمَحَ مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي في نفس اليوم وبالإجماع لبوتين باستخدام القوة العسكرية خارج روسيا. أمر الرئيس زيلينسكي بدورهِ بتعبئة جنود الاحتياط الأوكرانيين، وأعلنت أوكرانيا في 23 شباط/فبراير حالة الطوارئ على مستوى البلاد، باستثناء الأراضي المحتلّة في دونباس، ودخلت الحالة حيّز التنفيذ في منتصف الليل. بدأت روسيا في نفس اليومِ في إخلاء سفارتها في كييف وأنزلت أيضًا العلم الروسي من أعلى المبنى. تعرَّضت مواقع البرلمان والحكومة الأوكرانيين ومواقع البنوك لهجمات سيبرانية، في الساعات الأولى من يوم 24شباط/فبراير، ألقى زيلينسكي خطابًا متلفزًا وُصف بالعاطفي حيثُ خاطب فيه مواطني روسيا باللّغة الروسية وناشدهم لمنع الحرب مع اشتداد المخاوف والترقب، ظهر بوتين في 24 فبراير/ شباط في خطاب طويل استعرض من خلاله جملة اتهامات للسلطات الأوكرانية بوصفها سلطات تمارس النازية ضدّ الروس في أوكرانيا وإقليم الدونباس بشكل خاص، وتحارب الثقافة الروسية وتمنعها في البلاد، وبأنها تابعة للغرب وفاقدة للسيادة، وبأنها تسعى لجعل أراضيها قواعد للناتو، وأنها كذلك تسعى لتطوير أسلحة نووية مستفيدة من تركة وخبرات الاتحاد السوفييتي. ليعلن بوتين في خطابه عن بدء عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة أثر النازية منها»، وبدأ القصف على مواقع في جميع أرجاء البلاد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.
تحديات الأيام الأولى والمقاومة الشعبية
الأيام الأولى للغزو كانت عصيبة بالنسبة للأوكرانيين، لكنها كانت مليئة بالمفاجآت بالنسبة للجيش الروسي أيضاً، فالجيش الروسي الذي توقع إنهاء المعركة سريعاً وإسقاط حكومة كييف، فوجئ بمقاومة عنيفة من قبل الجيش الأوكراني، والمفاجئ أكثر هو المقاومة الشعبية التي بدأها الأوكران ضد الجيش، فلم يرحب أحد من الأوكران لا الذين يتكلمون الروسية ولا أولئك الذين يتكلمون الأوكرانية بالجيش الروسي، بل على العكس تماماً، قاموا بإمطار الآليات الروسية بالمولوتوف، فيما لعبت طائرات بيرقدار دوراً هاماً في توجيه ضربات للأرتال الروسية وإعطاب المئات منها، كما نجحت الدفاعات الأوكرانية على الرغم من تعرض قسم كبير منها للتدمير، في إسقاط طائرات مقاتلة ومروحيات روسية.
أوكرانيا نجحت في أسر مئات الجنود، وناشدت الصليب الأحمر بالتدخل لإجلاء جثث المقاتلين الروس الذين قدرتهم السلطات الأوكرانية بنحو 4500 جندي، وقد جرى تداول عشرات المقاطع يظهر فيها جثث مقاتلين روس والضرر البالغ الذي لحق بآلياتهم، وانقطاع بعض الآليات من الإمدادات بالوقود، ناهيك عن عشرات الأسرى الذين سمح لهم بالتواصل مع ذويهم لطلب المساعدة وإدراجهم في قائمة تبادل الأسرى.
هناك مسألة مهمة كذلك تستحق الوقوف، وهي التناغم الكبير في أوكرانيا بين القيادة السياسية والجيش والشعب، فكميات الدعم والتبرعات التي يقدمها الشعب للجيش كبيرة جداً وتستحق التقدير، والإقبال على التطوع في صفوف اللجان الشعبية وإغلاق الطرق والمساعدة في تجهيز الملاجئ في الأحياء الشعبية تجسد صورة لمقاومة شاملة في أوكرانيا تفسر إلى حد كبير تأخر الحسم لدولة قوية مثل روسيا، والتي اضطرت بعد فشلها في اقتحام عدة مدن في الأيام الماضية مثل خيرسون وخاركوف، إلى استخدام سياسة الأرض المحروقة واستهداف المدن والبلدات بالصواريخ الفراغية وصواريخ غراد وغيرها من أسلحة التدمير.
مآلات الصراع
ما يزال من المبكر التكهن بنتائج هذا الصراع، صحيح أن الإحصائيات والبيانات تشير إلى أن روسيا أقوى ربما بـ 20 ضعفاً من أوكرانيا، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق روسيا كانت قاسية وشديدة على الاقتصاد الروسي الذي يمثل نقطة الضعف، كذلك المساحة الشاسعة لأوكرانيا، والمقاومة في كل مكان، والأسلحة الدفاعية التي حصلت عليها أوكرانيا بعد أن أثبتت قيادتها جدارة في إدارة الأيام الأولى من الغزو، تجعل المهمة أصعب وأطول بالنسبة للروس، وتجعل من أوكرانيا ساحة لاستنزاف الروس، وربما مقدمة لاستنزاف الروس مجدداً في مناطق أخرى مثل سوريا.
تلفزيون سوريا
\
————————-
الغزو الروسي لأوكرانيا: تقدير موقف..!!/حسن خضر
يتصدّر الغزو الروسي لأوكرانيا كل قائمة محتملة للأسباب التي أدت إلى نهاية فصل، وبداية فصل جديد في تاريخ أوروبا والعالم، بصرف النظر عن المسوّغات والدوافع.
تبلور عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية على مدار سنوات قليلة أعقبت هزيمة ألمانيا النازية. ورغم أن مؤتمر يالطا (شباط 1945) حين تقاسم المنتصرون مناطق النفوذ، قد سبق الإعلان الرسمي عن نهاية الحرب (أيلول 1945) إلا أن ما أعقبه من تطوّرات وسياسات لم يحد بصورة راديكالية عمّا تجلى فيه من تسويات عامة، ومساومات، وخطوط تماس جديدة.
ولا أعتقد أن ثمة مجازفة في القول إن هذا كله قد انتهى، بعد سبعة وسبعين عاماً، في الفترة الواقعة من بين نهاية شباط، وأوائل آذار 2022، بمعنى أن مرحلة تاريخية، يمكن تعريفها بقدر من الطمأنينة، قد انتهت، وأن محاولة تعريف المرحلة الجديدة تفتقر إلى الحد الأدنى من الطمأنينة.
ولا بأس، في هذا السياق، من الاستعانة بعبارة لريجيس دوبريه الماركسي الفرنسي، الذي اقترن اسمه في وقت ما بتشي غيفارا، واليسار الجديد. تقول العبارة: “إن التاريخ يدخل الفصل الجديد مقنّعاً بقناع الفصل السابق”، لذا يعتقد الناس أن ما يرونه يتمثل في أحداث الفصل القديم نفسه، بينما تكون أشياء جديدة قد وقعت بالفعل.
لذا، يتصدّر الغزو الروسي لأوكرانيا كل قائمة محتملة للأسباب التي أدت إلى نهاية فصل، وبداية فصل جديد في تاريخ أوروبا والعالم، بصرف النظر عن المسوّغات والدوافع. وأود الإشارة، هنا، إلى أمرين أولهما “نظري” إلى حد ما، والثاني قراءة تحوّلات على الأرض.
1-وبقدر ما يتعلّق الأمر بالأوّل، فإن مقارنة سريعة بين العالم العربي (أعني الحواضر الشامية والمصرية والعراقية والمغاربية) وعالم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية تشير إلى التطوّر الكارثي للأوّل، والنجاح الاستثنائي للثاني، بكل المعاني الثقافية والإنسانية والسياسية.
هذا نقاش طويل وعريض، بطبيعة الحال، ولكن ما غاب عنه، وما قد يتضح مع مرور الأيام، أن مشكلة الأوّل ليست في الجينات، بل في سلسلة متلاحقة من الحروب الخارجية والداخلية، التي لم تنشأ، دائماً، وبالضرورة، نتيجة أنظمة دكتاتورية، وأيديولوجيات دينية صحراوية، وقوميات ريفية وحسب بل ونشأت لأن تضافرها مع عوامل خارجية، قاهرة، حرم بلاداً كثيرة من عوائد السلام، أيضاً. فثورات الربيع العربي لم تفشل إلا بعدما وجدت القوى المحلية للثورة المضادة التحريض والتشجيع من ممولين وداعمين وحلفاء تقليديين في الإقليم والعالم.
سمع أغلب مستهلكي هذا النوع من الأخبار، على الأرجح، عن الجامعة الإيطالية التي شطبت الروائي الروسي، وأحد أبرز الأعلام في تاريخ الرواية، ديستويفسكي، من المنهاج الدراسي. هذه ممارسة اعتباطية وحمقاء، بالتأكيد، ولا تختلف عمّا يقع في العالم العربي من أحداث تدل على حجم ما أصابه من انحطاط.
والواقع، أن هذه الحادثة تدل على أمور كثيرة من بينها ما يتجلى من ردود أفعال أوروبية، عفوية وغاضبة، تضاف إلى مواقف رسمية لا تقل عنها حماسة وبلاغة، احتجاجاً على الغزو الروسي. وفي حال تحوّل هذا كله إلى موضوع للاستثمار، والابتكار، والتنافس من جانب ساسة شعبويين، ومُحرّضين كانوا قبل قليل أشخاصا عاديين، وأصحاب أطوار غريبة أحياناً، صاروا متطوعين ومقاتلين، تكون أوروبا قد اقتربت من حافة الهاوية.
لا أعتقد أن هذا كله يعني وصول الأوروبيين إلى شيء يماثل الظاهرة الداعشية. فهذا يحتاج دفيئات أيديولوجية وسياسية، تحظى برعاية رسمية وشبه رسمية، ومصادر تمويل رسمية وشبه رسمية، قبل أن يشتد عودها، وتصبح قادرة على تمويل نفسها، ويحتاج، بالقدر نفسه، إلى مجتمعات مرضت وتعفّنت بالمعنى الحضاري والإنساني، حسب شواهد مألوفة في العالم العربي. فالنظام الصدامي، الذي بتر الأيدي، وجدع الأنوف، وسمل الأعين، كان حالة بربرية تماماً في سنواته الأخيرة. وهذه يصدق على الطريقة التي خاض بها النظام السوري حربه على معارضيه السلميين الأوائل، وصبّ بها الزيت على حطب الدواعش. أما بربرية الهوامش الصحراوية فحدّث ولا حرج.
بيد أن هذا كله لا يلغي حقيقة أن فترات الحرب في أوروبا كانت دموية، وأطول من فترات السلام، وأن فيها من الجراحات التاريخية، والضغائن القومية، والذكريات المسمومة، وخطوط التماس الرمزية، والأراضي المتنازع عليها، فعلاً (ليس في أوكرانيا التي قال بوتين إنها ليست دولة أصلاً وحسب، ولكن في أماكن كثيرة أيضاً) ما يكفي لإشعال أكثر من نار في أكثر من مكان، وتقويض عقود من السلام، حتى ما كان منه في زمن الحرب الباردة.
لذا، في حال طالت الحرب، وتعاظمت الخسائر البشرية والمادية، وفقدت الدول المركزية في أوروبا آليات الضبط والسيطرة، واستشرت الفوضى، وتوسّعت ظاهرة المقاومين والمتطوعين، وملحقات أمور كهذه كالدعاية والتحريض، والعمل السري، وسوق تجارة وتهريب السلاح، وتحويل القتال ضد عدو في الخارج إلى جزء من عملية الصراع على السلطة في الداخل، تكون أوروبا قد سقطت في الهاوية. ونرجو ألا يحدث ذلك.
2- أما الأمر الثاني، أي قراءة تحوّلات على الأرض، تشير إلى نهاية عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، فيتجلى في إعلان المستشار الألماني عن تخصيص ما يزيد على مائة مليار يورو لدعم موازنة الجيش خلال عام واحد. وقد نال إعلان المستشار الكثير من التصفيق وقوفاً من جانب الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان.
والمهم أن هذا تحوّل تاريخي، ولم يكن ليحدث دون موافقة الأميركيين، وكبار الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. بعد هزيمة النظام النازي واحتلال ألمانيا، فرض الحلفاء قيوداً على تسلّحها (كذلك على اليابان). وقد استمر هذا الوضع على ما هو عليه، مع تعديلات طفيفة على مدار عقود، ومن الواضح أنه انتهى الآن. وهذا يحتاج، بدوره، صياغة، وربما تأويلات جديدة، لمواد دستورية وثيقة الصلة بالجيش والمهام والعدة والعتاد.
وفي معرض البحث عن أسباب تحوّل يعتبر تاريخياً بمقاييس كثيرة، يمكن أن نضع على رأس القائمة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهزاته الارتدادية في أوروبا والعالم. ومع ذلك، لا يبدو من السابق لأوانه القول إن هذا التحوّل يمثل تتويجاً لمسار طويل أكثر من كونه عملية انعطاف حادة ومفاجئة. ومن الدوافع التي تستحق التفكير، في هذا الشأن، ما استخلص الأوروبيون من دروس خلال وجود ترامب في البيت الأبيض، والكثير منها قرع أكثر من جرس للإنذار.
فلم تعد حماية الأميركيين للسلم والأمن الأوروبيين مضمونة، ويمكن الرهان عليها بالمعنى الاستراتيجي، كما كان الشأن في زمن الحرب الباردة، وبعدها. ومع ذلك، وحتى في حال وجودها، والرهان عليها بقدر أقل من الطمأنينة، إلا أن أميركا في زمن دونالد ترامب جعلت منها موضوعاً للمساومة والإهانة والابتزاز (ففي أكثر من مناسبة أنتقد الرئيس الأميركي الألمان والأوروبيين لعدم دفعهم حصّة عادلة مقابل الحماية).
والمهم، بقدر ما يتعلّق الأمر بالدروس السلبية تضافرها مع تحوّلات مقلقة توحي بدخول أوروبا والعالم في طور جديد من أطوار الحرب الباردة. وهذا ما فاقم منه تسلّح الروس، وسلوكهم العدواني التوسعي، وتزايد الارتياب في إمكانية تحويل المصالح التجارية والاقتصادية المتبادلة مع الروس إلى ضمانات للأمن والسلام.
3-أخيراً، في الأفق احتمال لا نعرف تطوّراته اللاحقة، ولكنها (كائناً ما كانت) وثيقة الصلة، بما يحدث في أوكرانيا وأوروبا والعالم. قبل سنوات طرح عالم السياسة الأميركي جوزيف ناي السؤال التالي “هل سيكون القرن 21 أميركياً”. كان هذا السؤال، وما زال، على رأس القائمة في اهتمام خبراء السياسة والاستراتيجية الأميركيين، وفي كل مكان آخر على الأرجح.
المهم، وفي عجالة، يعتقد ناي أن لا أحد في العالم يستطيع تحدي وإزاحة القوّة الأميركية، عن القمّة، لأسباب تتعلّق بالقوة العسكرية والاقتصادية ومهارات الابتكار. لذا لا الصين، ولا روسيا، يمكنهما تحدي القوّة الأميركية. ولكن، إذا تحالفت القوتان الروسية والصينية تصبح حظوظ الأميركيين أقل بكثير.
لذا، ثمة ما يبرر مراقبة ما يفعل، وما لا يفعل، الصينيون، هذه الأيام، إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، طالما أن في الأمرين ما ينطوي على دلالات استراتيجية بعيدة المدى، وكلها تدخل، بالتأكيد، في حسابات مختلف القوى بشأن إطالة أمد الحرب، ومدى حدتها، واحتمال توسعها، وفقدان آليات الضبط والسيطرة.
درج
——————————–
الاستقطاب الثقافي يوقظ المصطلحات الأيديولوجية من سباتها/ حكيم مرزوقي
الأزمة الأوكرانية تقسم المثقفين العرب إلى معسكرين.
قد يتساءل بعضهم ما دخل المثقفين في ألاعيب السياسة وفي رحى الحروب المدمرة، لكن نظرة سريعة تكشف لنا الدور الكبير للمثقفين في ما يحدث، فهم مبررون لما يفعله السياسيون كل حسب أيديولوجيته، وهم مصطفون في النهاية مع فريق ضد آخر، وبالتالي فهم جزء هام من الصراعات، لكن في العالم العربي يبدو الوضع مختلفا ولو جزئيا.
المثقفون في العالم العربي ينقسمون عند كل أزمة سياسية تهز العالم، إلى معسكرين متخاصمين يتبادل كلاهما تهم التبعية إلى حد التخوين و”الوقوف ضد مصالح الأمة”.
نشهد الآن مثل هذا الاصطفاف الثقافي ذي الخلفية السياسية، على وقع ما يحدث في أوكرانيا من تطورات بعد الهجوم الروسي على أراضيها منذ أيام.
هذا الانقسام في الشارع الثقافي العربي ليس غريبا ولا مستجدا فهو جزء من ارتدادات وردات فعل تحدث في العالم بأسره إذا ما نظرنا إلى حجم الأزمة المتعلقة بالمواجهة بين أكبر قوى العالم بعد الحرب الكونية الثانية.
لا احترام للتاريخ
الكثير من المثقفين العرب مازال يمضي في أوهامه ويسرع إلى الاصطفاف السياسي قبل البحث في حيثيات ما يحدث
كأن المثقفين العرب لم يتخلصوا بعد من أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة قبل تسعينات القرن الماضي، فغالبيتهم، وعلى عكس نظرائهم الأوروبيين، مازالوا يظنون أن روسيا سوفيتية الهوى وهي تواجه الغرب الرأسمالي بنزعته التسلطية وأطماعه الاستعمارية.الغريب في هذا الاستقطاب الحاد بين مؤيدي روسيا من جهة، والمدافعين عن استقلال أوكرانيا وتبعيتها للغرب من جهة ثانية، أن الأمر في العالم العربي لا يخلو من رائحة الأيديولوجيا رغم عدم وجودها أصلا.
صحيح أن عالم القطب الواحد قد أثبت فساده وعدم جدواه بعد سقوط جدار برلين، لكن علينا ألا ننسى أن روسيا اليوم تخلصت بشكل نهائي من أي نزعة أيديولوجية ودفنت الشيوعية مرة واحدة وإلى الأبد، فهي تتضخم على نحو مختلف يجعل من المسألة القومية شوكتها الجديدة التي تعوّض “تصدير الثورة البلشفية”، خصوصا وأنها تنهل من إرث قيصري يريد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إحياءه عبر بروباغندا سياسية تمزج بين القيصرية والستالينية ضمن إخراج رأسمالي حديث.
وصحيح أن روسيا تستند إلى إرث ثقافي عملاق من شأنه أن يثير الانبهار ويدعو للتأني قبل الحكم على نظامها السياسي، لكن هذه الكنوز الأدبية والفنية أصبحت اليوم أشبه بمقتنيات أي متحف تاريخي.
لم يعد هذا الغنى الفني الممتد إلى عهد القياصرة على تواصل مع الواقع الثقافي لروسيا المعاصرة التي تعيش على إيقاع سلطة المال وما يصنعه من ثقافة الاستهلاك ويخلفه من مافيا المصالح والأسواق، بل وقع توظيفه لخدمة الرجل الذي يتباهى بعضلاته ويستعرض قدراته القتالية في رياضة الجودو، ويستقبل رؤساء العالم بصحبة كلبه وسط المنشآت القيصرية المدججة باللوحات والتحف والتماثيل.
كل هذا لا يعدو أن يكون مجرد توظيف لإرث ثقافي يدعي بوتين الانتماء إليه دون المشاركة في صنعه أو احترامه بشكل حقيقي، دون استعماله لغرض الترهيب السياسي والعسكري.
ولو كان النظام الروسي حريصا على احترام هذا الموروث الثقافي العظيم لنظر إليه بعين المسؤولية وقدّر الذاكرة الأدبية المشتركة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تعود، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن علماء وأساتذة التاريخ، إلى الدولة السلافية الأولى، “كييفان روس”، وهي إمبراطورية من القرون الوسطى أسسها الفايكنغ في القرن التاسع، ففي عام 988 بعد الميلاد، تحول فلاديمير الأول، أمير نوفغورود الوثني إلى الإيمان بالمسيحية الأرثوذكسية، وكان ذلك بداية تاريخ وثقافة متداخلة بين شعبين يشتركان في نفس الديانة، وترتبط لغاتهما وعاداتهما ومأكولاتهما الوطنية.
الطموحات السياسية لساكن الكرملين إذن، هي التي استهترت بهذا التاريخ المشترك بين الثقافتين، بالإضافة إلى نزعة السيطرة وعقدة التفوق الروسية التي تعود إلى عهد ستالين، والويلات التي ألحقها بفلاحي أوكرانيا مما جعل العديد من الأوكرانيين يرحبون بالغزو النازي عام 1941.
وكان القوميون الأوكرانيون بقيادة ستيبان بانديرا قد تعاونوا مع النازيين بهدف إقامة دولة أوكرانية مستقلة. وهذا ما يجعل إعلام بوتين اليوم، يصف حكومة أوكرانيا بـ”النازية” مستحضرا السردية الستالينية وهو ما يؤكد، وبالدليل، تمثل رجل المخابرات السوفيتية السابق، لمشروع ستالين الاستبدادي في المنطقة باسم الحفاظ على الوحدة الوطنية.
الاصطفاف الواهم
المثقفون في العالم العربي ينقسمون عند كل أزمة سياسية تهز العالم المثقفون في العالم العربي ينقسمون عند كل أزمة سياسية تهز العالم
المشكلة هنا أن العالم لم يتعامل مع المنظومة السوفيتية بعد سقوطها بنفس القدر الذي تعامل فيه مع النازية، إذ لا تزال روسيا تحمل طموحها السوفييتي وإن تخلت عن أيديولوجيتها الشيوعية. وهذا ما جعل الكثير من المثقفين اليساريين في العالم العربي تختلط عليه الأوراق ويأخذه الحنين بعيدا نحو روسيا وما كانت تمثله من رمزية قبل سقوط جدار برلين.
بالعودة إلى المثقفين العرب واصطفافهم سواء مع بوتين روسيا أو زيلنسكي أوكرانيا فإن الأمر لا يعدو أن يكون نوعا من التوهم بأن الأول يمثل “قوى التقدم” المدافعة عن كرامة الشعوب، والثاني “قوى الرجعية” المتحالفة مع الغرب الرأسمالي.
مثل هذه التسميات نهضت من سباتها هذه الأيام، وبتنا نسمعها على ألسنة بعض المثقفين العرب، في حين أن الأمر أبعد وأعقد من ذلك بكثير، فلا بوتين في قصره الشتوي يمثل مصالح الجماهير العربية، ولا زيلنسكي الفنان المسرحي الذي خذله الغرب الأوروبي والأميركي، يريد شرا بالمنطقة والعالم.
كل ما في الأمر أن الكثير من أهل الثقافة في البلاد العربية مازال يمضي في أوهامه ويسرع إلى الاصطفاف السياسي قبل البحث في حيثيات ما يحدث كما فعل من قبل أثناء حربي الخليج الأولى والثانية، وكذلك الحالة السورية وغيرها من موجات ما بات يعرف بـ”الربيع العربي”.
كذلك حدث في بلدان أوروبية أخرى لكن بأقل حدة وتشنجا على شاكلة الجامعة الإيطالية التي أوقفت تدريس أدب دوستويسكي، ومديرة المسرح الروسي التي استقالت احتجاجا على غزو بوتين لأوكرانيا.
كأن التاريخ يعيد نفسه على شكل مأساة تتجدد، وهو ما يذكر بقصيدة لتاراس شيفتشينكو (1814 – 1861) شاعر ورسام ومغن وسياسي وطني أوكراني، يعد مؤسس الأدب الأوكراني الحديث. ويقول في قصيدة “الغربان السود” وكان يجب تمزيقهم !/ تلك الدماء ضرورية، الدم الأخوي/ الحسد الذي بين الأخوة/ في البيوت، وأمام البيوت/ وعندما يعم المرح الكوخ/ نقتل الأخ ونحرق الكوخ/ هذا ما حصل غالبا/ هذا كل شيء، ولكنهم بقوا هناك/ أيتاما وحزانى.
كاتب تونسي
العرب
—————————–
مجلة ألمانية: هذه هي أكبر أخطاء بوتين العسكرية في غزو أوكرانيا/ علاء جمعة
مع تزايد أعداد اللاجئين الأوكرانيين الذين بدأوا بالوصول إلى ألمانيا، حيث تم تسجيل حوالي 18 ألف لاجئ، اليوم الجمعة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده لن تدخل في هذا الصراع، مستبعدا مشاركة جيش بلاده، وكذلك حلف الناتو، بأي شكل من الأشكال في الحرب، مؤكدا على العمل على الحلول الدبلوماسية، فيما لم يستعبد زعيم المعارضة تدخل حلف الناتو تحت ظروف معينة.
ومع استمرار الهجوم الروسي والتقدم البطيء الذي يحرزه الجيش على الأرض، رصدت مجلة “شبيغل” الألمانية أهم الأخطاء التي وقع فيها الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الحرب، معززة موضوعها بآراء خبراء استراتيجيين من حلف الناتو وأيضا خبراء مستقلين.
وبحسب المجلة، فقد تمكن الناتو من متابعة العملية العسكرية بطائرات الاستطلاع، إذ هاجمت القوات الروسية أهدافا في جميع أنحاء البلاد بصواريخ كروز. وما رآه محللو الناتو بدا مألوفا، فقد بدأ الغزو، كما توقع الاستراتيجيون العسكريون في جميع أنحاء العالم، بهجوم من النوع الذي يتم تدريسه في الأكاديميات العسكرية.
أصابت الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز محطات الرادار الأرضية الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية وأنظمتها الدفاعية المضادة للطائرات وقواعدها الجوية.
ويرصد التقرير الصحافي الألماني كيف شاهدت طائرات المراقبة الغربية عدة طائرات نقل ثقيلة روسية من طراز إليوشن Il-76 تحلق في مجالها الجوي، على ما يبدو في انتظار القضاء على الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات. ويفترض أنهم قد قاموا بعد ذلك بإنزال المظليين في مطار أوكراني. كانت الخطوة التالية تتمثل في قيام الطائرات المقاتلة الروسية بتدمير بقية الأسطول الجوي الأوكراني واكتساب التفوق الجوي. لكن هذا لم يحدث.
بعد ساعات من التحليق، استدارت طائرات إليوشن وعادت إلى مطاراتها الأصلية دون إكمال مهمتها. بقي الجزء الأكبر من المقاتلات الروسية على الأرض في البداية، وتراجعت الهجمات الصاروخية. يقدر خبراء الناتو أنه تم إطلاق حوالي 140 صاروخ كروز فقط استعدادا للغزو. وكان الخبراء قد توقعوا خمسة إلى عشرة أضعاف هذا العدد من الصواريخ الروسية.
تتابع المجلة أنه لاحقا ارتكب القادة الروس الخطأ الجسيم الثاني: لقد أرسلوا قوات برية إلى البلاد بالكاد محمية وفي وحدات صغيرة جدا. ويرى التقرير أن القوات المسلحة الروسية لم تتوقع مقاومة جدية من الجانب الأوكراني. على ما يبدو، صدرت أوامر للقوات بالتقدم بسرعة ومحاولة تطويق المدن الرئيسية، بدلاً من التقدم في وحدات كبيرة ومشكّلة، كما تملي العقيدة الروسية عادةً.
لم يحقق الجيش الروسي حتى الآن سيادة جوية كاملة على أوكرانيا، ولا تزال كتائبه تتعرض للهجوم الجوي من الجانب الأوكراني.
كانت الخطة الروسية على ما يبدو مفاجأة القوات الأوكرانية بتقدم سريع إلى كييف، إما اعتقال أو قتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنصيب حكومة “دمية” في كييف. وجاء في التقرير “لقد وضعوا قوائم مفصلة بالإعدامات”. قتل الشخصيات الرئيسية، وبالتالي كسر المقاومة. كان هذا لتجنب الحرب التي امتدت إلى البلد بأكمله. وأكد مسؤول رفيع المستوى في المخابرات الغربية لـ”شبيغل” وجود قوائم الموت هذه، إذ يعتقد العديد من الخبراء أن القتال من منزل إلى منزل في المدن الأوكرانية لم يكن جزءا من الخطة.
الحماقة الإستراتيجية
من المحتمل تماما أن يكون قادة روسيا قد وقعوا ضحية دعاية خاصة بهم بأن الأوكرانيين سيكونون سعداء بتحررهم من “النظام النازي” المزعوم. يبدو أن قلة قليلة من الناس في موسكو توقعوا مقاومة السكان، وأن عشرات الآلاف من الأوكرانيين سيحملون السلاح ويدافعون عن بلادهم.
وقد أدى التناقض الواضح في التنسيق بين مختلف أقسام القوات المسلحة إلى زيادة صعوبة التقدم، إذ ذكرت أجهزة المخابرات الغربية أن الوحدات المختلفة التي غزت أوكرانيا من الشمال لم تكن ببساطة مرتبطة تقنيا بشكل كاف، وكان على القادة اللجوء إلى الهواتف المحمولة المتاحة تجارياً والتي يسهل اعتراضها.
بدلاً من القوات الكبيرة المؤمنة بشكل جيد، تم إرسال الوحدات ذات التسليح الخفيف إلى عمق أراضي العدو دون دعم جوي. ووفقا لتقارير خبراء فإن “الأخطاء الإستراتيجية جنونية تماما فالروس لا يظهرون جيش قوة عظمى ولديهم نقاط ضعف مذهلة”. المثير للدهشة أن القوات الجوية الروسية بالكاد تدخلت في الحرب طوال الأسبوع الأول من الغزو. يعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى نقص الذخيرة الموجهة بدقة، ولكن أيضا لأن العديد من الطيارين الروس غير مدربين تدريباً كافياً.
بوتين يغير الخطة العسكرية
عدل بوتين إستراتيجيته في وقت سابق من هذا الأسبوع. المزيد من الصواريخ تحلق الآن، والمزيد من القنابل اليدوية، والقوات الروسية تطوق المراكز السكانية الرئيسية. وتخضع خاركيف لقصف صاروخي ومدفعي مستمر منذ يوم الإثنين. وتتزايد المخاوف من أن يقصف بوتين مدنا بأكملها وتحويلها إلى أنقاض، كما هو الحال في سوريا والشيشان، من أجل كسر إرادة القوات المسلحة الأوكرانية والميليشيات المتطوعة للقتال.
لكن المشاكل تتراكم باستمرار. طرق الإمداد تتعرض للهجوم، والبنزين والديزل والمواد الغذائية لا تصل إلى القوات المسلحة، أو تصل فقط بشكل غير كاف. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المئة من القوات الروسية في أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الغذاء والوقود، ويشكو الجنود من الجوع والبرد. وانطلقت قافلة عسكرية روسية يبلغ طولها 60 كيلومترا متجهة إلى كييف يوم الإثنين ولم تصل بعد إلى المدينة. وهي عالقة حاليا على بعد حوالي 30 كيلومترا من وسط المدينة.
من ناحية أخرى، يرصد التقرير الألماني نجاحا للجيش الروسي في جنوب أوكرانيا. فالجيش الروسي أكثر نجاحا هناك بكثير حيث تمكنت القوات البرية من إنشاء ممر من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. تم الاستيلاء على مدينة خيرسون الساحلية يوم الخميس. كما يبدو من الممكن إنشاء ممر بري من روسيا إلى مقاطعة ترانسنيستريا المولدوفية الانفصالية. في الوقت نفسه، تم قطع وصول أوكرانيا إلى بحر آزوف، وسرعان ما تم قطع البحر الأسود.
ويخشى المحللون أنه بمجرد إغلاق الحصار حول كييف وخاركيف، ستندفع القوات الروسية لاقتحام المدن حيث يحتاج بوتين بشدة إلى النجاح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الضحايا بشكل كبير. ستكون حرب المدن عملية مكلفة للقوات الغازية، وإذا حدث ذلك، فقد تستمر الحرب لأشهر.
“سيناريوهات الحرب”
يقوم الخبراء حاليا بتصميم سيناريوهات مختلفة حول كيفية استمرار الأمور. وهم يتفقون على أن بوتين بالكاد يمكن أن ينتصر في هذه الحرب على المدى الطويل. قد يقهر أوكرانيا عسكريا، لكنه لن يكتسب سيطرة حقيقية لأن لديه الشعب ضده. ويرى بعض المحللين أن بوتين قد يتمكن من تعديل أهدافه والتفاوض على سلام مع كييف والتي لن يفكر فيها إلا إذا كان بقاء نظامه على المحك. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى الإطاحة ببوتين.
ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا في الوقت الحالي هو أن يسمح بوتين لجيشه بمواصلة القتال في أوكرانيا لأسابيع وشهور. أجهزة المخابرات الغربية تتوقع بالفعل “خسائر فادحة” في الأيام المقبلة. وقال مسؤول استخباراتي غربي كبير لـ”شبيغل” إن القوات المسلحة الروسية “ستحاصر المدن، وتقصفها بشدة ثم ينتقلون من منزل إلى منزل”. ويعتقد محللون أن بوتين يمكن أن يهدف إلى تقسيم البلاد واحتلال الشرق وأجزاء من الشمال، بما في ذلك كييف.
القدس العربي
——————————-
نخب روسية تقرأ المواجهة مع الغرب حسب «عقيدة بوتين»/ وائل عصام
يعتبر سيرغي كاراغانوف، وهو من منظري السياسة الخارجية الروسية، أن «أوكرانيا بلد فاشل، وعبء على أي دولة تستحوذ عليها، وهو مشكلة أمنية بالنسبة لروسيا»، لكن لا بد من تحييدها ثم تركها، بحسب كاراغانوف الذي يرى أن الصراع في أوكرانيا مقدمة لانهيار الغرب، إذ يركز المفكرون المقربون من الكرملين ومراكز البحث، على أن الحرب في أوكرانيا هي مجرد وجه من أوجه النزاع مع الغرب والناتو، معتبرين تلك الحرب بداية لانهيار الغرب، كما يقول كاراغانوف: «في الوقت الحالي، يمضي الغرب في طريقه نحو الانهيار، وإن كان بشكل بطيء، ولكنه حتمي، سواء من حيث الشؤون الداخلية أو الخارجية، أو حتى الاقتصاد. وهذا الوضع تحديدا هو سبب اندلاع هذه الحرب الباردة الجديدة، بعد ما يقرب من (500) عام من الهيمنة العالمية للغرب على السياسة والاقتصاد والثقافة، وهو ما توّج بشكل خاص في التسعينيات، بعد انتصاره الحاسم الذي استمر حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين».
تثق النخبة الروسية المقربة من عقيدة بوتين الاستراتيجية، بأن الغرب سيخسر المعركة، وكاراغانوف أحدهم، الذي يقول: «ما أعتقده أن الغرب على الأرجح سيخسر هذه المعركة، وسيتنحى جانبا عن مركز القيادة العالمي ليصبح شريكًا»، مضيفا إلى ذلك أهمية وجود الصين كقوة وكحليف لموسكو، لإحداث توازن مع الغرب، الذي لم يكن يرى روسيا، إلا «ضواحي متخلفة» بحسب تعبيره.. «ستحتاج روسيا إلى موازنة العلاقات مع الصين الصديقة، ولكنها الأكثر قوة أيضا على نحوٍ متزايد». أما الاستراتيجي والسياسي ألكسندر نازاروف، فهو يتحدث عن عمق الخلاف التاريخي مع الغرب قائلا، إن «الغرب يريد التدمير المادي لكل شيء روسي في العالم». ويشبهه بقيام الرومان القدماء برش الأرض بالملح، بعد استيلائهم على قرطاج، حتى لا ينمو أي شيء آخر هناك. ويعتقد نازاروف، أن العزلة ستجعل روسيا أكثر قوة في مواجهة ما يعتبره الانهيار الحتمي للنظام المالي العالمي، «وعندما يصبح العالم المترابط والمتكامل بشكل متبادل في حالة خراب، بعد انهيار نظام الدولار وهرم الديون العالمية، فإن روسيا وحدها هي التي ستبقى واقفة على قدميها». ويذهب بعيدا في تصور مآلات الصراع متوقعا، أن أي نزاع سيؤدي بطرف من الطرفين للتهلكة والفناء كدول، «سواء أبقيت روسيا في هذا العالم أم لا، سواء انتصرت أم لا، فلن يكون في نهاية الصراع أي ولايات متحدة أمريكية أو غرب على هذا الكوكب، أو على الأقل لن تكون هذه الكيانات في الهيئة نفسها أو في الدور نفسه الذي تلعبه الآن».
ويبدو أن هذه اللهجة الحادة حول الصراع بين الروس والغرب لها تراث وخلفية تاريخية مشحونة، فالمؤرخ الروسي نيكولاي كرامزين، كتب قائلا في (رسائل رحالة روسي عام 1792): «في الطريق إلى كونيغسبرغ، دهش ألمانيان عندما علما أن روسياً يمكنه التحدث بلغات أجنبية، وفي لايبزيغ، تحدث الأساتذة عن الروس على أنهم برابرة. أما الفرنسيون فقد اعتبرونا قروداً لا تعرف إلا كيفية التقليد». وينقل عن كاتب فرنسي قوله: «لقد بدا على الروس شيء من الحضارة في مظهرهم الخارجي، إلا أنهم ما زالوا برابرة تتار تخفي ملابسهم الأوروبية جلد الدب تحتها». ويذكرنا هذا بمقال الكاتب المصري أنيس منصور ذكر فيه مرة، أن الروس كانوا يغضبون من سماع بعض الأمثال الأوروبية مثل «إذا غضب الروسي ظهر التتري الذي في داخله».
—————————–
بالاستبعاد من نظام “سويفت”.. هل ينجح “سلاح المال النووي” ضد روسيا؟
موسكو: اتخذ الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قرارات عقابية بحق روسيا، الأربعاء الماضي، منها استبعاد الاخيرة من نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت” كرد فعل على العملية العسكرية التي أطلقتها ضد أوكرانيا.
ويُستهدف بهذه العقوبات إعاقة الصادرات والواردات الروسية عن طريق تصعيب قيامها بأي معاملات مالية في أي مكان بالعالم.
وكانت روسيا قد تعرضت لتهديد مشابه عام 2014، وأعلن وزير المالية الروسي آنذاك ألكسي كودرين إن قرار استبعاد بلاده من نظام “سويفت” يمكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 في المئة.
ومع أن وضع الاقتصاد الروسي في 2022 أفضل منه عام 2014، إلا أن من المتوقع أن يؤدي قرار الاستبعاد من نظام سويفت إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الروسي.
لا يوجد إجماع بالاتحاد الأوروبي بخصوص القرار
ووفقاً لتعبير وزير المالية الفرنسي فإن قرار الاستبعاد من سويفت يعد بمثابة “سلاح نووي مالي”، ويمكن للدول الغربية بواسطته أن تسبب مشاكل كبيرة لروسيا في المدفوعات الدولية والصادرات والواردات.
لكن القرار سيؤثر بالسلب أيضاً على الدول التي اتخذت القرار، لذلك نرى أن هذا القرار غير مدعوم بالإجماع في الاتحاد الأوروبي.
مثلاً ترى برلين أن “سلاحاً مؤثراً كهذا سيؤثر على رجال الأعمال والصناعة في ألمانيا، لذلك فإن الاستبعاد من نظام سويفت يجب أن يكون ضد أهداف معينة وأن هذا – السلاح النووي المالي – يجب ألا يستخدم إلا في محله وألا يُسمح بأن يضر هذا القرار الاقتصادات الأوروبية”.
وستضر هذه العقوبات بالدول المعتمدة على روسيا في الحصول على أي سلعة، وسيضطر رجال الأعمال في الدول التي اتخذت القرار للبحث عن وسائل بديلة وأنظمة أكثر تعقيداً لمواصلة التجارة مع روسيا.
أما الحل الآخر فسيكون البحث عن بديل لروسيا إلا أن كل الدول وفي مقدمتها الدول التي تدعم القرار، تعلم جيداً أنه لا يمكن العثور على بديل لروسيا على المدى القريب، وخصوصا في مجال الطاقة.
دول تدعم القرار على استحياء
تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) في بلجيكا عام 1973 بهدف إجراء معاملات تحويل النقد الأجنبي بين البنوك. وهي نظام تواصل يربط 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة ومنطقة.
وكان قد تم استبعاد إيران من النظام، ما سبب ذلك أضراراً بالغة لتجارتها. وأُدرجت روسيا بنظام سويفت عام 1989، وتشكل معاملاتها اليومية 1,5 في المئة من إجمالي المعاملات بالنظام.
تتصرف بعض الدول بالاتحاد الأوروبي بحذر فيما يخص بالعقوبات على روسيا بسبب كون الأخيرة هي المورد الأول للبترول والغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي. لأن المعاناة مجدداً من ارتفاع أسعار الطاقة سيكون نزيفا جديدا للاقتصادات التي بدأت في التعافي مؤخرا من تداعيات كوفيد-19.
الحكومات لا ترغب في توقف إمدادات الطاقة أو زيادة جديدة في الأسعار. وكانت ألمانيا من بين الدول التي وقعت على قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت على استحياء، وذلك بسبب ارتباطها بروسيا في الحصول على الطاقة ومخاوفها من قيام روسيا بالرد على هذه الخطوة.
هل تمتلك روسيا بديلاً لنظام سويفت؟
هُددت روسيا في السابق بالاستبعاد من نظام سويفت بسبب أزمة شبه جزيرة القرم وفي عام 2014 طورت روسيا نظام الدفع الخاص بها SPFS وبدأت اختبار هذا النظام واستخدامه مع بعض الدول.
ومع استبعادها من نظامي فيزا وماستركارد عام 2016 بدأت روسيا استخدام نظام بطاقات الدفع الخاص بها MIR إلا أن هذين النظامين لم يُستخدما إلا على نطاق ضيق.
تأثير القرار على تركيا
ضمت القائمة غير النهائية التي أعلنتها الولايات المتحدة والمفوضية الأوربية عدة بنوك روسية هي ” بنك أوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”روسيا بنك” و”برومسفيازبنك” و”في تي بي” و”في إي بي” وسوفكومبنك”. وتم التخطيط لتقليل الضرر الواقع على الدول المتعاملة مع روسيا في قطاع الطاقة ولذلك اُستثنيَ “سبيربنك” الذي يعد أكبر بنك في روسيا و”غازبروم بنك” لأهميته بالنسبة لقطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن تتأثر تركيا من الأزمة بين روسيا وأكرانيا في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة. إلا أنه ليس من المتوقع توقف التجارة معها تماماً لأنه من الممكن مواصلة عمليات الدفع بواسطة البنوك الروسية المستثناة من القرار.
شكل السياح الروس والأوكرانيون نحو 27 في المئة من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا عام 2021. ومن المحتمل أن يتأثر عدد السياح كثيراً في صيف العام الجاري بسبب تأثر اقتصادي البلدين من الحرب.
كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى تأثر تركيا التي تعاني من نسب تضخم مرتفعة.
الوضع النهائي
سيسبب الاستبعاد من نظام سويفت مشاكل كثيرة لروسيا فيما يخص بمدفوعات الصادرات والواردات، وسيزيد من تكلفة البحث عن طرق بديلة. إلا أن استثناء بعض البنوك الروسية من القرار سيخفف من التأثيرات السلبية.
ومن ناحية أخرى سيضر بالاقتصاد الروسي بسبب تراجع الصادرات وفرض قيود على احتياطات البنك المركزي الروسي على الساحة الدولية، ما سيؤدي ذلك إلى تراجع العملة الروسية وارتفاع التضخم.
ولن يقتصر تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي فقط بل سيؤثر أيضاً بطريقة غير مباشرة على الدول التي لديها تجارة مع روسيا. مثلاً سيؤدي ارتفاع التضخم في روسيا وتراجع قيمة الروبل إلى انخفاض في عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة تكلفة استيرادها على الاتحاد الأوروبي وبالتالي زيادة التضخم.
وإذا ما قابلت روسيا قرار الاستبعاد من نظام سويفت بتقليص صادراتها، سيؤثر ذلك على الإنتاج والصناعة وسيرفع التكلفة ويسبب مشاكل في أمن الطاقة بالدول التي تتعامل مع روسيا وفي مقدمتها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
سيوضح إعلان القائمة الرسمية للبنوك الروسية المستبعدة من نظام سويفت، مدى الضرر الذي سيلحق بروسيا ودول أخرى من هذا القرار.
وبالنظر إلى العقوبات الإضافية نجد أن روسيا وكل النظام العالمي الذي يتاجر معها سيتأثر من قرار الاستبعاد من نظام سويفت.
وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينتبه جيداً حتى لا تؤثر هذه العقوبات بصورة مباشرة على صادرات البترول والغاز الطبيعي الروسية. لأنه لن يرغب أحد في أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الغاز والنفط التي تصدره والذي لا يمكنها الحصول على ثمنه بسبب قرار سويفت. ولذلك من الصعب وصف قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت بشكل حذر بأنه “سلاح نووي مالي”.
(الأناضول)
————————
بوتين يتوعّد من يشارك بحظر جوي على روسيا: العقوبات أشبه بإعلان حرب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا “أشبه بإعلان حرب”، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى “نزع سلاح” كييف.
وهدد بوتين أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي، بأن “أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد سنعتبرها مشاركة مباشرة في النزاع”.
وبخصوص التفاوض مع كييف، قال الرئيس الروسي: “طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد”، وفق ما نقلت “رويترز”.
وقبل تصريحات بوتين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الغاضبة لا تمنحه تفاؤلا بشأن مصير محادثات إنهاء العمليات الحربية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه مستعد لمحادثات مع لافروف، لكن في حالة واحدة أن تكون المفاوضات “هادفة”.
واتهم الكرملين، في وقت سابق اليوم الغرب بأنه يتصرف “مثل العصابات” مع روسيا، مضيفاً أن موسكو “أكبر” من أن يعزلها أحد، والعالم “أكبر” من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن الغرب يشن “حرب عصابات اقتصادية” على روسيا، مضيفاً أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقاً للمصالح الروسية.
وأضاف في هذا السياق: “نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية”. ورغم ذلك، أكد بيسكوف أن أميركا “تُبقي بعض قنوات الحوار مع موسكو”، متابعاً القول: “نأمل أن يتفهم الاتحاد الأوروبي وأميركا وحلف شمالي الأطلسي موقفنا”.
التحديثات الحية
اجتياح أوكرانيا: موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بشأن إفشال خطة الإجلاء
وفي الملف الاقتصادي، قال المتحدث الروسي إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة. ودخل الاجتياح الروسي لأوكرانيا، السبت، يومه العاشر، مع تعرّض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرق البلاد لـ”حصار” يفرضه الجيش الروسي، ولهجمات “عنيفة”، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، في وقت أعلنت فيه موسكو أنها ستسمح بممرات آمنة في أوكرانيا.
وأعلنت أوكرانيا، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 10 آلاف.
—————————-
سقوط رهانات بوتين: هكذا تأسست مقاومة لروسيا شرق أوكرانيا/ سامر إلياس
تحت شعار حماية السكان من أصل روسي في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في حوض دونباس، شرقي أوكرانيا، “الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، ما سماها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.
وفي خطابه الذي أعلن فيه الحرب، أضاف بوتين: “لهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الروسي، إلى العدالة”، مشدداً في الوقت نفسه على أن خطط روسيا “لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية”.
كما ادّعى بوتين في خطابه أن “الإبادة الجماعية ضد ملايين الأشخاص الذين يعيشون في دونباس”، كانت وراء قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، بغية “إيقاف هذا الكابوس”، على حد وصفه.
وسبق ذلك تقديرات على نطاق واسع تفيد بأن روسيا وفي حال لجوئها للخيار العسكري، ستحصر عملياتها في جبهة دونباس، للعديد من الأسباب، وهذا يصبّ في الاتجاه ذاته الذي حدَّده بوتين في خطاب إعلان الحرب.
لكن لم تمض سوى ساعات قليلة حتى تكشّف أن الحرب اتخذت مسار غزو شامل لأوكرانيا، على عكس كلام بوتين وما ذهبت إليه غالبية التحليلات، بما يملي إعادة النظر في الكثير من الفرضيات التي استند إليها المحللون والمراقبون لتطور مسار الأزمة الأوكرانية، ومنها حيثيات ترجيح فرضية حصر عمليات الجيش على جبهة دونباس.
العامل الديمغرافي والحسابات الخاطئة
وتفرض المراجعة الأخذ بعين الاعتبار نقطتين هامتين: النقطة الأولى وقائع المعارك في منطقة شرق أوكرانيا. والنقطة الثانية التحول في الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي الروسي، بتركيزه بعد انطلاق الأعمال العسكرية على أن جوهر الصراع يتمثل بالحفاظ على أمن ومصالح روسيا أولاً، وأن ذلك يتطلب تقديم ضمانات بأن تكون “أوكرانيا محايدة”، إلى جانب “الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن”، بالإضافة إلى “الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم”.
وعلى الرغم من تضمين الشروط أيضاً شرط الاعتراف بما يسمى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إلا أن الكثير من التصريحات الروسية لم تقدمه كشرط مسبق، بل أقرب إلى كونه جزئية تفاوضية، يمكن وضعها على طاولة المفاوضات في مرحلة لاحقة، عند البحث في تسوية سياسية شاملة لمسألة دونباس.
وتبين النقطة الأولى أسباب تغير الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي الروسي، ولماذا لم يصمد طويلاً المبرر الذي قدمه بوتين كسبب لشن الحرب على أوكرانيا، واللجوء إلى خيار غزو واسع لأراضيها.
فمن أهم المفاجآت التي تفجرت في الساعات الأولى من الحرب، المقاومة الشرسة التي واجهتها القوات الروسية في منطقتي شرق وجنوب شرق أوكرانيا.
واتضح لاحقاً أن ذلك لا يعود فقط إلى التحضيرات والاستعدادات التي قامت بها أوكرانيا، إنما إلى واقع مختلف في المنطقتين لم يُرصد سابقاً بشكل دقيق، ما أدى إلى خطأ في الحسابات لدى القيادة السياسية والعسكرية الروسية، وفي تقديرات المحللين والمراقبين.
الحسابات والتقديرات كانت تنطلق من اعتبار منطقة شرق أوكرانيا، وبدرجة أقل منطقة الجنوب الشرقي، الخاصرة الرخوة لكييف في أي مواجهة عسكرية مع روسيا، بناء على كون نسبة كبيرة من السكان المحليين هناك من أصول روسية، والتشكيك في مدى ولائهم للحكومة الأوكرانية، والارتباط الوثيق تاريخياً بين روسيا وهذه المناطق سياسيا واقتصادياً، ووجود نزعة انفصالية وقومية راديكالية قوية تغذيها وتدعمها موسكو.
والخطأ هنا ليس في وجود تلك الظواهر من عدمه، فهي موجودة بالفعل، لكن يبدو أنه تمت المبالغة في حجمها وقوة تأثيرها في أوساط المواطنين الأوكرانيين من أصول روسية، ويعود ذلك إلى عدم رصد وتحليل التغيرات التي طرأت عليها خلال السنوات الماضية.
ويؤكد ما سبق صمود وحدات الجيش الأوكراني ولجان المقاومة الشعبية، وخوضها مواجهات قوية وعنيفة في لوغانسك ودونيتسك ومدينتي خاركيف وماريوبول، وما كان ذلك ليتحقق لولا وجود حاضنة شعبية واسعة داعمة للجيش الأوكراني والمقاومة، ورافضة للحرب الروسية.
وهذا يفسر بدوره لماذا استبعدت موسكو خيار شن حرب هجينة ضد كييف، وإدارة حرب بالوكالة عبر الانفصاليين الموالين لها، وسبب فشل كل المحاولات التي بذلتها خلال السنوات الثماني الماضية لتحويل مشاريع الانسلاخ الثقافي كأداة لإدماج سكان المنطقة سياسياً مع روسيا.
وقبل ذلك لماذا فشلت روسيا عام 2014 في تمكين الانفصاليين من الحفاظ على المناطق التي سيطروا عليها في شرق أوكرانيا، مثل مدن كسلافياسك وكراماتورسك وزديرجينسك وكونستانتينوفكا وغيرها.
تلاعب بالوقائع والأرقام
من أسباب الفشل، محاولة روسيا التعمية على النسب الحقيقية للسكان المحليين من أصل روسي في لوغانسك ودونيتسك، كون اللغة الرئيسية في المنطقتين هي الروسية.
ويبلغ العدد الإجمالي لسكان منطقة لوغانسك 2.2 مليون نسمة، حسب إحصائيات عام 2014، يشكل الأوكرانيون منهم ما يقارب 58 في المائة والروس 39 في المائة. ويبلغ العدد الإجمالي لسكان منطقة دونيتسك 4.3 ملايين نسمة، يشكل الأوكرانيون منهم ما يقارب 57 في المائة والروس 38 في المائة.
ومن الأسباب أيضاً، النتائج السلبية لسياسات روسيا القائمة على عزل المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون عن باقي الأراضي الأوكرانية، بهدف إدماجها سياسياً واقتصادياً وثقافياً مع روسيا، ومنح أكثر من 820 ألف نسمة من سكان المنطقة الجنسية الروسية والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات الروسية، والحصول على امتيازات مثل معاشات تقاعدية وضمان اجتماعي وتسهيلات للدخول في سوق العمل الروسي. إلا أن نسبة وازنة من سكان تلك المناطق بقيت تفضل الارتباط بأوكرانيا.
شخصية وطنية أوكرانية
كما ثبت عدم دقة مقولة وجود ارتباك كبير لدى سكان شرق أوكرانيا، بين جنسيتهم الأوكرانية والتأثير الروسي المكثف، ما يدفعهم للميل إلى جانب من ستكون له الغلبة.
فالمقاومة القوية للغزو الروسي في هذه المنطقة ضد الغزو الروسي، أكدت أن هذه المقولة مبالغ فيها، وأن الغالبية تتمسك بالانتماء إلى أوكرانيا، على الرغم من الإشكالات والتقلبات والتحديات، السياسية والاقتصادية، التي عانت منها البلاد منذ استقلالها.
وأوكرانيا استطاعت أن تُدخل إصلاحات هيكلية واسعة أرست أسس التداول السلمي للسلطة، وهامشاً ديمقراطياً واسعاً، بالمقارنة مع روسيا وغالبية دول الاتحاد السوفييتي السابق.
وخلال ثلاثة عقود من الاستقلال نظّمت كييف سبع عمليات انتخابية رئاسية تداول فيها السلطة ستة رؤساء، بالإضافة إلى ألكساندر تورتشينوف الذي انتخب كرئيس مؤقت من البرلمان عام 2014، بعد فرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وبينما تشكّل السياسات التي ينتهجها بوتين عاملاً نابذاً للأوكرانيين ككل، يبدو أن السنوات الماضية شهدت اندماج الناطقين باللغة الروسية داخل مجتمعهم بمعدل تسارع أكبر بكثير مما كان متوقعاً، ويرون أن مستقبلهم سيكون أفضل مع أوكرانيا، التي سيتيح لها انضمامها للاتحاد الأوروبي فرصاً كبيرة لاستنهاض أوضاعها الاقتصادية.
وبالتالي لا تستطيع روسيا ضمان ولاء السكان المحليين في منطقة شرق أوكرانيا ككل، ولم يكن باستطاعتها المراهنة على خوض حرب هجينة ضد أوكرانيا من إقليم دونباس، في وقت ثبت فيه خفوت الدعوات الانفصالية حتى في أوساط المؤيدين للتيارات والأطر المصنفة كمؤيدة لروسيا. وهذا ليس جديداً فقد دلت استطلاعات للرأي عام 2014 على ضعف رغبة سكان شرق أوكرانيا في الانفصال.
شكوك في النجاح بضم دونباس
وبدا واضحاً أيضاً أن قدرة الانفصاليين على تعبئة الأقلية الروسية محدودة جداً. ويؤخذ على موسكو أن دعايتها لم تكن مقنعة في شرق أوكرانيا، وطُرحت العديد من الأسئلة حول مدى تحكمها بتوجهات سكان المنطقة.
ولهذا كان وما زال من المشكوك به أن تنجح موسكو في تأمين غطاء سياسي لضم دونباس من خلال إجراء استفتاء كما فعلت في شبه جزيرة القرم عام 2014.
وتطرح اليوم أسئلة حول إمكانية أن يستتب لروسيا الأمر في هذه المنطقة مستقبلاً بعد السيطرة عليها عسكرياً. ناهيك عن أن الاحتلال سيكون مكلفاً مادياً، لأن على روسيا أن تتحمل المسؤوليات التي ستلقى على عاتقها كدولة محتلة، كإدارة وتشغيل المرافق العامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من إمدادات الطاقة والتدفئة والمواد الغذائية والأدوية، وهي مهمة صعبة ويزيد من صعوبتها العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على روسيا.
ومن الواضح أن المقاومة العنيفة في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا وتكاتف جميع الأوكرانيين على اختلاف انتمائهم العرقي لصدّ الهجوم الروسي، كشفت أن العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت شخصية وطنية جامعة لمعظم الأوكرانيين تراهن على الخيار الأوروبي والتوجه غرباً.
والأرجح أن الأيديولوجية القومية المتشددة ذات اللبوس الديني التي انتهجها بوتين في السنوات الأخيرة، والتضييق على الحريات والعودة إلى سنوات القمع الستاليني (أيام الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين بين عامي 1922 و1952) في مجال قمع الصحافة الحرة والمعارضين السياسيين، ساهمت في التقليل من جاذبية النموذج البوتيني في الحكم، ومقاومة محاولة فرضه على أوكرانيا التي تنفست نسائم الحرية منذ “الثورة البرتقالية” في 2004.
هذا الوضع يفرض على بوتين، المولع بمحاضرات التاريخ القديم والمعاصر لروسيا، إجراء مراجعة شاملة لأفكاره لا تنطلق من أن التاريخ “جثة هامدة”، فالأسس التي بنى عليها سرديته التاريخية بشأن عدم وجود دولة أوكرانية، عفا عليها الزمن.
ويبدو أن “الأخوّة” التي طالما تحدث عنها بوتين بين الروس والأوكرانيين تلقت ضربة قاتلة نتيجة العملية العسكرية الشرسة التي حوصرت فيها المدن وقصفت بالصواريخ، ولم يتم فتح ممرات إنسانية إلا بعد مفاوضات مع قيادة أوكرانيا الحالية.
ولعل الأخطر أن باقي بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، التي تضم أقليات روسية وازنة، باتت تخشى من طموحات “سيد الكرملين” الراغب في إعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية، ما قد يتسبب في نظرة أخرى للروس هناك على أنهم “قنابل بوتين الموقوتة” لزعزعة استقرار أي شعب يحلم بالديمقراطية والتوجه نحو الطريق الأفضل من دون إملاءات “الأخ الأكبر”.
وفي المعادلة الداخلية فإن تأثيرات الحرب يمكن أن تتسبب في زيادة مخاوف القوميات الصغيرة في روسيا والتي عانت كثيراً في عهد القياصرة، خصوصاً أن روسيا دولة متعددة القوميات بما تضمه من روس وتتار وأوكرانيين وغيرهم من شعوب الاتحاد السوفييتي السابق.
———————————–
بوتين يخنق الحريات أم تخنقه؟/ بسام مقداد
منذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا عممت اللجنة الروسية للإشراف على الإعلام Roskomnadzor حظر إستخدام كلمات حرب، هجوم أو إجتياح لوصف الغزو، وإعتبار هذه التعابير بمثابة معلومات “كاذبة” عن “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا. وتتوالى هذه الأيام من روسيا الأنباء عن الصحف والمواقع الإعلامية التي يتم حظرها أو إقفالها نهائيا بسب إستخدام تعبير “حرب”. وكان آخر هذه المواقع إذاعة “صدى موسكو” الممولة بشكل أساسي من العملاق “غاز بروم” المملوك من الدولة، حيث اتخذ مجلس إدارتها الخميس المنصرم قراراً بإقفالها نهائيا بعد قرار حظرها في الأثير. وتبعها في اليوم عينه (3 من الشهر الجاري) موقع شبكة التلفزة المعارضة Dojd بإعلان المدير العام قي أثير الشبكة عن وقف البث، “حيث نحتاج وقتاً لنفهم كيف نعمل لاحقاً”.
صحيفة Novaya المعارضة هي الأخرى، كما سواها من المواقع المهددة بالعقوبات المالية الكبيرة أو الحظر لمدة محددة، إجتمعت هيئة تحريرها مطلع الشهر الجاري للبحث في إمكانية الإستمرار بالصدور في ظل هذا التضييق الخانق على الإعلام، وقررت أن تطرح على قرائها مسألة الإستمرار بالصدور بشروط اللجنة المشرفة على الإعلام أو الإقفال. جاء رد القراء، في العدد الذي أصدرته ويتضمن فقط تعليقاتهم على السؤال، بأن طالبوها بالاستمرار وهم سيفهمون ما تكتب وما بين سطوره.
العديد من الصحافيين والكتاب السياسيين المعارضين الذين طلبت منهم “المدن” التعليق على هذه المسألة أو تلك المتعلقة بغزو أوكرانيا، إما اعتذروا عن الرد أو أنهم، وعلى غير عادتهم لاذوا بالصمت. وقال أحد العاملين في موقع معارض، اشترط ألا يذكر إسمه وإسم الموقع الذي ينتمي إليه، بأن على “المدن” أن تتفهم وضع الإعلام المعارض وعمله في هذه الظروف الخانقة، حيث تتحين السلطة الفرصة إما لإدراج الموقع “المخالف” على قائمة العار “عملاء أجانب” أو إقفاله نهائياً. ويقول مواطنون روس في التواصل معهم بأن الوضع لا يطاق، ويخشون التحدث على الهاتف بموضوع الحرب. ووصف آخرون الحالة بأنها تطبِق على صدور الجميع وتضيق أنفاسهم، ويشبهونها بالحالة التي سادت المجتمع الروسي في ثلاثينات القرن الماضي، ذروة الإرهاب الستاليني.
لكن إذا كانت بعض المواقع الإعلامية الروسية تقرر الإستمرار بالصدور، إما بالتحول إلى الإعلام الإلكتروني الذي يتيح طرقاً متعددة للصدور أو التحايل على شروط السلطة للإستمرار في الدفاع عن حرية التعبير، ومناهضة الحرب، قررت إدارة الخدمة الروسية في”الحرة” و “اوروبا الحرة” الرد على محاولات خنق حريتها بمقاضاة السلطة الروسية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان موقع الخدمة الروسية في “الحرة” قد نشر أواسط الشهر المنصرم نصاً بعنوان “”الحرة، وأوروبا الحرة تواصلان السعي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمعاقبة روسيا”. وكانت المحكمة قد منحت وضع الأولوية لدعوى الهيئة الأميركية المالكة للموقعين، والتي تشتكي من تدهور ظروف عمل الصحافيين في روسيا، وتعترض على 70 طلباً من هيئة الإشراف على الإعلام الروسية بحذف مواد متعلقة بالتحقيقات في قضية المؤسسة المناهضة للفساد للمعارض الروسي السجين ألكسي نافالني. وصرح حينها رئيس الهيئة المالكة جيمي فلاي بالقول “في محاولته لتأكيد سيطرته الكاملة على المعلومات، يحاول الكرملين تجريم الصحافة ووصف الصحافيين الروس بالخونة. ندعو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إصدار حكم بشأن ما إذا كان يمكن اعتبارها قانونية القوانين المتعلقة بـ “العملاء الأجانب” التي تنتهك الحقوق الأساسية للصحفيين ولجميع مواطني روسيا”.
وكان موقع “الحرة”، الذي أدرج مع سواه في قائمة “عملاء أجانب” منذ العام 2017، يرفض أن يقدم لمواده المنشورة بالتعبير المذل الذي يفرضه القانون الروسي المعني، والذي تقول السلطات الروسية بأنها أقرته رداً على القانون الأميركي المماثل المفروض على مواقع الإعلام الروسية في الولايات المتحدة. وذكر الموقع أن مجموع الغرامات التي أقرتها المحاكم الروسية بحقه بلغ حينها حوالي مليار روبل (كان الدولار يساوي 70 روبلاً في حينه).
موقع ovdinfo الروسي المدافع عن حقوق الإنسان نشر في 2 الشهر الجاري نصاً بعنوان “منذ بداية الحرب ( التي ترفض السلطة الروسية تسميتها حرباً) نشهد ضغطاُ هادفاً غير مسبوق على وسائل الإعلام المستقلة. منذ اليوم الأول طلب Roskomnadzor من وسائل الإعلام أن تنشر عن الحرب في أوكرانيا فقط ما تنشره المصادر الروسية الرسمية”. ويعدد الموقع 11 موقعاً إعلامياً تلقى طلباً من السلطة بحذف مواد عن العمليات العسكرية “لعدم مطابقتها الحقيقة لقصف الجيش الروسي المدن الأوكرانية ومقتل سكان مدنيين”. المواقع المذكورة ليست جميعها مستقلة معارضة، بل تضمنت صحيفة القوميين الروس وموقع نوفوستي الذي يتولى ترجمة الصحافة الأجنبية وموقع شبكة تلفزة رسمية إقليمية.
يقول الموقع أن وقف عمل المواقع الإعلامية بدأ في 17 الشهر المنصرم، ويشير إلى أن القوى الأمنية سحبت من الأسواق في 2 الشهر الجاري أعداد 5 صحف كتبت على صفحاتها الرئيسية “يجب وقف هذا الجنون”. ويشير إلى أن كل هذا الذي يجري لا يمكن وصفه إلا بأنه أشد أنواع الرقابة التي يحظرها الدستور الروسي. والحرب هي ذلك الوضع الذي يجب أن يتلقى فيه الناس، أكثر من أي وضع آخر، المعلومات من مصادر مختلفة. وقراء المواقع المعنية الناطقين بالروسية، أوكرانيا بالنسبة لهم هي وطن، أسرة، أصدقاء، مكان عمل وذكريات، وجميع هؤلاء بحاجة إلى معلومات متنوعة المصادر. ومن المعروف كيف تقدم السلطة المعلومات، وكم هي الحقائق التي تسكت عنها وتشوهها حتى في زمن السلم، “فكيف في زمن الحرب”. وكثيرون لا يثقون بالمصادر الرسمية للمعلومات، بل يلجأون إلى المصادر المستقلة. وقد حُرموا الآن عملياً من هذه الإمكانية، ووسائل التحايل المتاحة لا توفر كل الإمكانيات الضرورية لتخطي الحظر.
ويضيف الموقع بالقول، الدولة تقصف أراضي اوكرانيا، أناس يموتون، تتضرر مدن كثيرة، وسكان روسيا يحرمون من المعلومات. تتعرض للملاحقة أيضاً التصريحات المناهضة للحرب، ولم يسبق مثيل لحجم إعتقالات الناس الذين بخرجون إلى الشارع للتعبير عن مناهضتهم للحرب. ويختتم نصه بشعار “لا للحرب! لا للرقابة!”.
حرب بوتين على أوكرانيا فتحت الباب على مصراعيه لحربه الرديفة على حرية الكلمة في روسيا، وهو يدرك أنه يراهن بمصيره في الحربين. فليس للتراجع والإنسحاب من مكان فيهما: إما أن ينتصر ويستمر في قلعته المعزولة عن العالم، لا يزعجه فيها صوت معارض، وإما يهزم في الحربين معاً، وهذا ما تلوح تباشيره في صمود أصحاب الكلمة الحرة في روسيا وفي صمود الشعب الأوكراني في الإسبوع الثاني لمواجهة آلة بوتين العسكرية الهائلة.
وفي سياق صمود أهل الكلمة الحرة الروس أتت إستقالة رئيسة تحرير الخدمة الروسية في عملاق بروباغندا الكرملين RT ماريا بارونوفا في 2 الجاري من موقعها. وقالت في اليوم الأخير لشبكة التلفزة المحظورة Dojd ” لقد أصبحنا في كوريا الشمالية”. وبارونوفا هي إحدى نجمات إنتفاضة 2011 ــــــ 2012 ضد الكرملين، وزج بها في السجن حينها وتواصل الآن إنتفاضتها ضد بوتين وحربه على أوكرانيا، وثباتها مع الأوكرانيين على ما هي عليه يشي لمن ستكون الغلبة في معركة الحريات.
المدن
————————————
بوتين يشترط لوقف النار..الاستجابة لجميع المطالب الروسية
حثّ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القتال “فوراً” في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي الجمعة، وجاء في بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن “شولتس أعرب خلال الاتصال عن قلقه الكبير” من الحرب في أوكرانيا.
ودعا المستشار الألماني شولتس الرئيس الروسي إلى “وقف فوري للقتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب”. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار شولتس تحدث هاتفياً مع بوتين ودعا موسكو إلى “وقف كل الأعمال العسكرية على الفور”.
من جانبه، قال الرئيس الروسي للمستشار الألماني خلال الاتصال إن جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستعقد خلال أيام، مؤكداً أن الحوار غير ممكن من دون تنفيذ كل المطالب الروسية.
وذكر الكرملين أن الاتصال جاء “بمبادرة من ألمانيا”، وأن “روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن بشرط أن تلبى كل المطالب الروسية”. وأكد بوتين لشولتس رغبته في أن تصبح أوكرانيا أكثر إيجابية في المفاوضات المقبلة.
من جانب آخر، استبعد شولتس مشاركة الجيش الألماني بأي شكل من الأشكال في الحرب في أوكرانيا. وقال شولتس خلال زيارته لقيادة عمليات الجيش الألماني بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية: “لسنا جزءاً من الصراع العسكري الدائر هناك ولن نكون كذلك..عدم مشاركة الناتو والدول الأعضاء في هذه الحرب أمر جلي بالنسبة لنا تماماً”.
كما أكد شولتس أن الحكومة الألمانية ستبذل كل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار، وقال: “الصور التي نراها بالفعل للدمار مروعة بما فيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى المزيد”.
وتم التخطيط لزيارة المستشار لقيادة عمليات الجيش الألماني قبل وقت طويل من بدء الحرب في أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن شولتس نفسه “معارض أخلاقي”، أي يعارض الخدمة العسكرية، وأكمل خدمته المجتمعية في هامبورغ في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
وفي مقابل تصريح بوتين أنه منفتح على الحوار مع أوكرانيا بشرط تنفيذ جميع مطالبه، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لن يقدم تنازلات تقوّض وحدة بلاده.
ومع دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها التاسع، تتواصل المعارك في محاور مختلفة في ظل المحاولات لتحقيق مزيد من التقدم من جانب القوات الروسية، والتصدي لها من الجانب الأوكراني.
مواقف الدول في مجلس الأمن
وعقد مجلس الامن جلسة لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية. ودعت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة الرئيس الروسي خلال الجلسة إلى “الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتوقف عن هذا الجنون”.
بدوره، قال مندوب ألبانيا بالامم المتحدة: “مجلس الأمن يعود إليه إنقاذ أوكرانيا وشعبها من الجحيم الذي تدفعها روسيا إليها”، داعياً روسيا إلى “إنهاء اعتدائها على أوكرانيا وسحب جيوشها”.
من جهتها، دعت مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة روسيا إلى “إنهاء العنف في أوكرانيا وسحب قواتها والانخراط في مفاوضات جادة”، وقالت: “بوتين استخف بإدانة العالم لتصرفاته ويجب ألا يتكرر هجوم روسيا على أكبر منشأة نووية في أوروبا”.
———————
عودة “حرب النجوم” الأميركية الروسية؟
تساهم صور تلتقطها أقمار اصطناعية تجارية في بث مجريات الحرب في أوكرانيا بعدما كانت تقتصر سابقاً على وكالات التجسس، فتنقل صور قافلة عسكرية روسية ضخمة تشقّ طريقها إلى كييف وضربات صاروخية، وصولاً الى عبور لاجئين الحدود. وتبرز أيضا التكنولوجيا القادرة على خرق الغطاء السحابي والعمل ليلاً، فيما يقدّم جيش متزايد من المحللين الاستخباراتيين تقييماً فورياً تقريباً للتطورات في ساحة المعركة.
وقال كريغ نازاريت، وهو ضابط استخبارات أميركي سابق بات باحثاً في جامعة أريزونا، لـ”فرانس برس”: “لم تعد الحكومات الطرف الوحيد الذي يمكن الحصول منه على بيانات عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية”.
وبفضل النمو الكبير الذي شهده قطاع الأقمار الاصطناعية الخاصة، باتت كمية الصور الملتقطة أكبر والمدة الزمنية التي يستغرق وصولها أقصر مقارنة بما كان عليه الحال في نزاعات سابقة، عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم العام 2014 مثلاً. وبينما تملك معظم الحكومات الغربية أقماراً اصطناعية متطورة خاصة بها، لا تسمح طبيعتها السرّية بمشاركة الصور. وبعدما اهتزّت ثقة العامة في الحكومتين الأميركية والبريطانية، في أعقاب حرب العراق العام 2003، ساهمت الصور الملتقطة من قبل أطراف ثالثة في سد ثغرات المصداقية. وأفاد نازاريت “إنهم يقولون: أنظروا، لسنا نحن، الأمر يحدث فعلاً، لا نختلق ذلك”. وفضلاً عن دورها في صياغة سردية الأحداث، تساعد الصور مباشرة القوات الأوكرانية في الحرب.
وفي بيان، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “كابيلا سبيس” Capella Space إنها “تعمل مباشرة مع حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا وغيرها من الكيانات التجارية لتقديم بيانات حديثة والدعم بشأن النزاع الجاري”.
ويذكر ذلك بـ”حرب النجوم”، التي استعرت لسنوات بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، أيام الحرب الباردة، سوى أنها الآن حرب الأقمار الاصطناعية وصُورها عالية الدقة والقادرة على الاتهام وربما الإدانة في مجريات قانونية لاحقة محتملة.
وأدركت مجموعة من الباحثين المستقلين بأن الغزو بدأ بفضل صور التقطتها شركة ناشئة في سان فرانسيسكو، قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انطلاق “عمليات عسكرية خاصة” في أوكرانيا صباح 24 شباط/فبراير. وقبل ساعات من هذا الخطاب، نشر جيفري لويس من “معهد ميدلبري” في كاليفورنيا تغريدة تفيد بأن “خرائط غوغل” تكشف وجود “ازدحام مروري” على الطريق من بيلغورود في روسيا إلى الحدود الأوكرانية. وكانت تلك النقطة المحددة حيث شاهدت “كابيلا سبيس” في وقت سابق قافلة من المركبات العسكرية، وكان الاختناق المروري على الأرجح نتيجة وجود مدنيين روس عالقين عند حواجز لدى مرور مركبات عسكرية. وقال في فرضية ثبتت صحّتها “هناك تحرّك”. وبينما تحتاج غالبية الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية إلى ضوء النهار وأجواء صافية لالتقاط الصور، تعتمد “كابيلا سبيس” على “رادار الفتحة التركيبية” synthetic aperture الذي تنتج أجهزة الاستشعار الخاصة به الطاقة ومن تم تسجّل الكمية التي تنعكس من المصدر.
وقال نائب رئيس قسم منتجات الشركة دان غيتمان إن رادار SAR “يخترق السحاب والدخان، حتى في حالات العواصف الشديدة أو الحرائق، فنتمكن بكل ثقة من التقاط صور واضحة ودقيقة للأرض في ظل أي ظروف تقريباً”.
وتعد شركة “بلاك سكاي” من تلك التي تم استخدام صورها بكثافة من قبل وسائل الإعلام، وبثت ما تعتقد أنه من بين الاشتباكات الأولى للحرب، وهو الهجوم على محطة لوغانسك الحرارية للطاقة بعد الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي في 23 شباط/فبراير.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة برايان أوتول لفرانس برس “لدينا مجموعة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي يمكن أن ترى من الفجر حتى الغسق، وليس فقط في أوقات معينة من اليوم”.
وفي المدارات القطبية التقليدية التي تحلق من الشمال إلى الجنوب، يمكن للقمر الاصطناعي التقاط صورتين فقط من بقعة معينة في اليوم، لكن “بلاك سكاي” تنقل أجهزتها عكس اتجاه عقارب الساعة لدوران الكوكب، ما يسمح لها بالعودة إلى الموقع بشكل متكرر. ويتلقى العملاء الصور في غضون 90 دقيقة، ويتم مساعدتهم في تفسيرها بواسطة برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وربما كانت الصورة الأكثر تأثيراً في النزاع حتى الآن تلك الملتقطة لقافلة روسية يبلغ طولها 64 كيلومتراً التقطتها “ماكسار” التي وصفها كريس كويلتي من شركة “كولتي أناليتكس” Quilty Analytics بأنها “الأكثر شهرة في القطاع”. ويوضح كويلتي أنه، على عكس الأقمار الاصطناعية التقليدية التي تشير فقط إلى الأسفل، تحتوي أقمار “ماكسار” على جيروسكوبات تسمح لها بالدوران وتحديد الهدف بمزيد من الدقة. وتعد حكومة الولايات المتحدة، من خلال مكتب الاستطلاع الوطني، أحد العملاء الرئيسيين لـ”ماكسار”، حيث تملي “وقت الالتقاط”، وهو ما يفسر سبب تكريس الشركة وغيرها الكثير من الوقت لأوكرانيا حالياً.
لكن البث الانتقائي لما تراه الأقمار الاصطناعية قد يثير في النهاية مخاوف أخلاقية.
وقال كويلتي إن أقمار “ماكسار” ومثيلاتها “تلتقط حتماً صوراً لتحركات القوات الأوكرانية والمواقع الدفاعية، ولا يتم نشر هذه المعلومات للعامة”. وأفاد أنه في ما يخص النزاعات المستقبلية “هناك قدرة مطلقة على تشويه السردية اعتماداً على الصور التي يتم توفيرها”.
——————————–
“بي.بي.سي” تعلق عملها في روسيا بعد تجريم الصحافة المستقلة
فرضت السلطات الروسية قيوداً على الوصول إلى موقع خدمة “بي بي سي” الناطقة باللغة الروسية، وطاولت القيود أيضاً، خدمات إخبارية أخرى منها دويتشه فيله، وميدوزا، وإذاعة ليبرتي، وفي المقابل حظرت لندن استقبال قناة “روسيا اليوم” لما تروجه من “دعاية” بحسب المسؤولين في حكومة بوريس جونسون.
وأعلن رئيس هيئة “بي بي سي” تيم دايفي، الجمعة، أن المؤسسة الإعلامية البريطانية ستوقف تغطيتها في روسيا مع إقرار تشريع جديد “يبدو أنه يجرم الصحافة المستقلة”. وأضاف أن هذا الأمر “لا يترك لنا إي خيار آخر سوى التعليق الموقت لعمل كل صحافيي الأخبار في “بي بي سي” وطواقم الدعم لهم داخل اتحاد روسيا ريثما نقيِّم التداعيات الكاملة لهذه المستجدات المؤسفة”.
ومرّر البرلمان الروسي قانوناً يجرّم نشر معلومات “كاذبة” عن القوات المسلحة. ويعترض الكرملين على وصف الصراع الدائر في أوكرانيا بالـ “حرب”، مُطلقاً عليه وصف “عملية عسكرية خاصة”.
وفي بريطانيا، اختفت قنوات “روسيا اليوم” (RT) من جميع وسائل البث في البلاد.
وتأثر الوصول لشبكة روسيا اليوم في بريطانيا بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من عدم استمرار لندن في الاتحاد، إلا أن فرض التكتل عقوبات على شركات الأقمار الاصطناعية في لوكسمبرغ وفرنسا أثر على بث شبكة سكاي التي تقوم ببث روسيا اليوم. وعلقت الشبكة الروسية على الحظر بالقول: “لقد انهارت أخيرا واجهة الصحافة الحرة في أوروبا”.
وعبّرت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، والتي سبق أن وصفت القناة بـ”آلة بوتين للدعاية الملوثة”، عن أملها ألا تعود هذه القناة إلى الشاشات في بريطانيا. وقالت دوريس في حديثها أمام مجلس العموم، أمس الخمس: “قناة روسيا اليوم لن تعمل في أي منزل بريطاني بأي وسيلة، وهذا نتاج لتضافر الجهود والنقاشات”. وتابعت: “تواصلنا مع تيك توك وميتا (الشركة المالكة لفايسبوك) لنطالبهما بألا يبثا روسيا اليوم عبر منصتيهما”.
—————————–
وثائق سرية حول غزو أوكرانيا..بوتين أراد إنجازه ب15 يوماً
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها عثرت على خطط معركة سرية خلفها الجنود الروس، أظهرت أن موسكو تخطط لحرب تستمر 15 يوماً. وأضافت أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها نُشرت على فيسبوك، وأظهرت خططاً حربية لإحدى وحدات الكتيبة التكتيكية لأسطول البحر الأسود الروسي.
وتشير الوثائق التي عثرت عليها القوات الأوكرانية “خريطة للغزو” وجدول إشارات مشفرة وقائمة بأسماء أشخاص، وفقاً لموقع”بزنس إنسايدر”.
وثيقة خلفها جنود روس لخطط غزو أوكرانيا
وعزت وزارة الدفاع الأوكرانية الفضل في الحصول على هذه الوثائق إلى “الإجراءات الناجحة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية”، مشيرة إلى أن “المحتلين الروس لا يخسرون المعدات والقوى البشرية فقط بل يتركون خلفهم وثائق سرية بسبب الذعر”.
وقالت إنه بناء على الوثائق، فقد وافقت روسيا على غزو أوكرانيا في 18 كانون الثاني/يناير 2022، وكان يفترض أن تستمر العملية 15 يوماً من 20 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس.
مجزرة تشيرنيغيف
وارتفع عدد قتلى غارة روسية على مدينة تشيرنيغيف، شمال أوكرانيا إلى 47 قتيلاً الجمعة، على ما نقلت وكالة “رويترز”. وكانت غارة روسية قد استهدفت حياً سكنياً في مدينة تشيرنيغيف الأوكرانية الخميس، أدت إلى مقتل 33 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن يرتفع العدد إلى 47 صباح الجمعة. وأظهرت مشاهد نشرها جهاز حالات الطوارئ دخاناً يتصاعد من شقق مدمرة وركاماً على الأرض ومسعفين ينقلون جثثاً.
وكتب حاكم المنطقة، فياتشيسلاف تشاوس، في حسابه على تطبيق تلغرام: “هاجم سلاح الجو الروسي مدرستين في منطقة ستارا بودودوفكا، وعناصر الإنقاذ يعملون”.
وفي السياق، قالت وكالة “رويترز” نقلاً عن مستشار الرئيس الأوكراني إنه تم صد محاولات من القوات الروسية للتقدم في مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب البلاد. وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن قوات كييف تصدت لمحاولات القوات الروسية الهادفة للتقدم في مدينة ميكولايف، وأنه لا يوجد تهديد وشيك لمدينة أوديسا المجاورة.
وتحدثت تقارير إعلامية نقلاً عن عمدة مدينة ميكولايف أن القوات الروسية دخلت المدينة وأن قتالاً عنيف يدور في عدد من الأحياء خصوصاً الواقعة منها في أطراف المدينة.
معركة كييف
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة، إن القوات الروسية تحاول تطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، لافتة إلى أن القوات الروسية تم “ايقافها” في منطقة ماكاروف على بعد 60 كيلومتراً عن العاصمة.
واضافت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة الروسية استنفدت معظم احتياطياتها التشغيلية وبدأت “الاستعدادات لنقل قوات وموارد إضافية من المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية”.
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد قالت في وقت سابق إنّ المعارك مع القوات الروسية مستمرة في مدينة هوستوميل في محيط العاصمة كييف، ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن القوات الأوكرانية تمكّنت من تدمير 20 عربة روسية مصفحة خلال معارك الخميس.
القافلة الروسية المتجهة لكييف متوقفة
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تصريحات لشبكة “بي بي سي” عن وجود ثلاثة أسباب لتأخر القافلة العسكرية الروسية باتجاه كييف، أولها المقاومة الأوكرانية الشرسة، والأعطال الميكانيكية لآليات القافلة، واكتظاظ الآليات في الطريق، بينما صرح مسؤول أميركي في وزارة الدفاع بأن القافلة تعاني من نقص في الوقود والطعام، وأن الروس سيتعلمون من هذه الأخطاء والعثرات، وسيحاولون التغلب عليها.
وبحسب “بي بي سي”، فإن تفسيرات متعددة يمكن تقديمها للتأخر، أهمها المشاكل اللوجيستية، والمقاومة غير المتوقعة، والسبب الإضافي المتعلق بانخفاض معنويات الجنود الروس.
وإضافة إلى ما ذكر من مشاكل لوجيستية متعلقة بالطعام والوقود؛ تحدثت الشبكة عن مشاكل صيانة تعاني منها الآليات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بأجهزة اتصالات القافلة.
——————————–
“غزو أوكرانيا”.. كييف مهددة بالتطويق ووقف “محدود” لإطلاق النار
يدخل غزو موسكو لأوكرانيا يومه العاشر بتوجه القوات الروسية لتطويق العاصمة كييف، في خطوة كانت قد أسست لها خلال الأيام الماضية على جبهتين، الأولى من الشمال والثانية من الشرق.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، إن القوات الروسية تتقدم في بعض الاتجاهات، لكنها تسيطر على مساحة صغيرة فقط.
وأضاف ريزنيكوف أن القوات الروسية تستخدم إمكانياتها الجوية والصاروخية بشكل غير مسبوق، موضحاً أنها تعمل حالياً على تطويق العاصمة كييف، لكن القوات الأوكرانية تتصدى لها.
ولا تقتصر محاولة القوات الروسية في التطويق على العاصمة كييف، بل تتعرض مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد لذات السيناريو.
في المقابل أكد رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو أن الروس يحاصرون المدينة الواقعة على بحر آزوف جنوبي أوكرانيا، ويشنون “هجمات بلا رحمة” عليها.
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز“: “منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا التي يسكنها نحو نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة”، داعياً إلى “مواصلة المقاومة”.
وتابع “نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار”، مؤكداً أن “أولويتنا هي وقف إطلاق النار، حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية، وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة”.
سقوط صاروخ باليستي روسي على حي سكني في شمال كييف. pic.twitter.com/AidLtmWsIt
— أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 5, 2022
وأعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول، ومدينة ثانية بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن “الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح، اعتباراً من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.
وعلى وقع التطورات المتسارعة على الأرض لا تبدو حتى الآن ملامح تهدئة.
وقد ذكر ميخايلو بودولاك مستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم، أن جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية قد تعقد السبت أو الأحد.
لكن فرص تحقيق تقدم تبدو ضئيلة جداً، بحسب ما تشير إليه تصريحات المسؤولين الروس، على رأسهم فلاديمير بوتين.
NEW: Here is the latest #Russian control-of-terrain #map for #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats. pic.twitter.com/urQi5VrxO2
— ISW (@TheStudyofWar) March 4, 2022
وكان بوتين قد حذر، قبل أيام، من أن الحوار مع كييف لن يكون ممكناً إلا إذا تم قبول “كل المطالب الروسية” بما في ذلك ضمان وضع أوكرانيا كدولة “محايدة وغير نووية” و”إخلائها الإجباري من السلاح”.
ولم تفض جولتان سابقتان من المحادثات على الحدود الأوكرانية البيلاروسية ثم على الحدود البولندية البيلاروسية، إلى وقف القتال، لكن الطرفين اتفقا على إقامة “ممرات إنسانية” لإجلاء المدنيين.
وتتضارب الأرقام بعد عشرة أيام من الغزو الروسي، ما بين كييف وموسكو.
وبينما أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلاً في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي، تحدثت كييف عن مقتل أكثر من تسعة آلاف جندي روسي.
في حين فر أكثر من 1,2 مليون لاجئ من أوكرانيا، حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.
—————————-
تلغراف: سيناريوهات التضليل الروسي في سوريا تتكرر بأوكرانيا
نشرت صحيفة تلغراف البريطانية، مقالاً لمراسلتها جوزي إينسور، تحدثت فيه من تجربتها عندما تعرضت قبل سنوات إلى القرصنة الإلكترونية من قبل مجموعة تابعة للحكومة الروسية.
وحمل المقال عنوان “لقد استُهدفت من قبل آلة الدعاية الروسية في زمن الحرب في سوريا.. يجب أن نخاف على أوكرانيا”.
وقالت إينسور: “في صباح 22 نيسان 2018 وصل البريد الإلكتروني من نائب رئيس الأمن في مايكروسوفت يقول إن فريق استخبارات التهديدات في الشركة اكتشف دليلاً على أني مستهدفة من قبل مجموعة APT التابعة للدولة”.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أجرت إينسور مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس عبر خدمة الرسائل المشفرة سيغنال أخبرها فيها أن روسيا هي الجاني، وإنها لم تكن أول صحفي يتم استهدافه.
وأضافت أن “القراصنة الإلكترونيين بدأوا في إنشاء حسابات على موقع لينكد إن والبريد الإلكتروني باسمي بهدف تشويه تقاريري عن الحرب السورية ونشر معلومات مضللة قد تكون ضارة”.
وأشارت إلى أن روسيا تدعم نظام الأسد و”تقريري لا يتناسب مع روايتهم، لم يكن من المحتمل أن يكون الأسد وراء ذلك، فقد احتج مسؤولو الحكومة الروسية على وسائل الإعلام الحكومية، وتعهدت موسكو بإزالة مخزون دمشق الكيماوي قبل بضع سنوات”.
وأدرفت: “بذل الكرملين جهوداً متضافرة خلال ذروة الصراع السوري لمحاولة تشويه سمعة المعارضة، وشمل ذلك الإعلام الغربي”، مؤكدة أنه “على مر السنين، أصبحت روسيا واحدة من أكثر مزودي العالم براعة للتضليل والتلفيق”.
وختمت بالقول إن هدف حملة التضليل الروسية الأكثر استمراراً هو الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، مشيرة إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اتهم يوم الثلاثاء أوكرانيا بتزوير مقتل مدنيين، وقارن الفعل المفترض بقتلى سوريين، “تتمثل الإستراتيجية الأخرى لروسيا في إغراق النظام البيئي الإعلامي بأكاذيب مصممة لتقويض ثقة الجمهور”.
——————————
المواجهة الروسية مع الناتو مجرد بداية/ سيرغي كاراغانوڤ
من التدمير البنّاء إلى إعادة التجميع
يبدو أن روسيا دخلت حقًا نحو حقبة جديدة من سياستها الخارجية، يمكن تسميتها بنهج “التدمير البنّاء” لنموذج العلاقات السابق مع الغرب– شوهدت بوضوح أجزاء من طريقة التفكير الجديدة هذه على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وذلك منذ خطاب ڤلاديمير پوتين الشهير في مؤتمر ميونيخ عام 2007 – لكنَّ كثيرًا من نمط التفكير هذا قد أصبح واضحًا الآن بالتزامن مع تلك الجهود الباهتة للاندماج في النظام الغربي، مع الاحتفاظ بالموقف الدفاعي الصلب عن مصالحنا، وهو ما مثل الاتجاه العام في الخطاب والسياسة الروسية.
عملية التدمير البناء الحالية ليست عدوانية؛ حيث تؤكد روسيا أنها لن تهاجم أو توجه ضرباتها إلى أي جهة: “هذه العملية ببساطة لا تحتاج إلى ذلك”. توفر الظروف الخارجية الحالية في العالم مزيدًا من الفرص الجيوسياسية لروسيا لتنمية مصالحها على المدى المتوسط، مع وجود استثناء واحد، وهو توسع حلف الناتو عبر إدماج أوكرانيا فيه، بشكل رسمي أو غير رسمي، مع ما يمثله ذلك من خطر كبير على أمن البلاد، وهو ما لن تقبله موسكو ببساطة.
في الوقت الحالي، يمضي الغرب في طريقه نحو الانهيار، وإن كان بشكل بطيء، ولكنه حتمي، سواء من حيث الشؤون الداخلية والخارجية، أو حتى الاقتصاد. وهذا الوضع تحديدًا هو سبب اندلاع هذه الحرب الباردة الجديدة بعد ما يقرب من (500) عام من الهيمنة العالمية للغرب على السياسة، والاقتصاد، والثقافة، وهو ما توّج بشكل خاص في التسعينيات، بعد انتصاره الحاسم الذي استمر حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ما أعتقده أن الغرب على الأرجح سيخسر هذه المعركة، وسيتنحى جانبًا عن مركز القيادة العالمي ليصبح شريكًا، وهو الشكل الأكثر منطقية. وفي لحظة ليست بالمبكرة: “ستحتاج روسيا إلى موازنة العلاقات مع الصين الصديقة، ولكنها الأكثر قوة أيضًا على نحوٍ متزايد”.
في الوقت الحاضر، يحاول الغرب يائسًا الدفاع عن هذه الهيمنة عبر خطابه العدواني الحالي الذي يهدف إلى توحيد معسكره، واللعب بما تبقى لديه من أوراق رابحة لعكس هذا الاتجاه. إحدى هذه الأوراق محاولة استخدام أوكرانيا لإلحاق الضرر بروسيا وتحييدها. من المهم في هذا الشأن منع هذه المحاولات المتشنجة الحالية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أن تتحول إلى مواجهة شاملة؛ لأن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية وخطيرة، على الرغم من عدم إدراك الغرب نسبيًا لخطورة هذا النهج. لا يزال يتعين علينا إقناع الغربيين بأنهم فقط يضرون أنفسهم.
الورقة الرابحة الأخرى هي الدور المهيمن للغرب في نظام الأمن الأوروبي- الأطلسي الحالي الذي تأسس في وقت كانت فيه روسيا ضعيفة بشكل حاد في أعقاب الحرب الباردة. هناك ميزة تكمن في هدم هذا النظام تدريجيًا، ويعود ذلك- في المقام الأول- إلى رفض المشاركة فيه واللعب وفقًا لقواعده التي باتت بالية، وغير مواتية بطبيعتها لنا. بالنسبة إلى روسيا، يجب أن يصبح المسار الغربي ثانويًا بالنسبة إلى دبلوماسيتها الأوراسية- قد يؤدي الحفاظ على العلاقات البناءة مع الدول الواقعة في الجزء الغربي من القارة الأوروبية إلى تسهيل اندماج روسيا في منطقة أوراسيا الكبرى، ولكن النظام القديم يحول دون ذلك؛ ولذا لا بد من تفكيكه. سيكون من الرائع لو كان لدينا مزيد من الوقت للقيام بذلك، لكن التاريخ يُظهر أنه منذ انهيار الاتحاد السوڤيتي قبل 30 عامًا، فقط قلة من دول ما بعد الاتحاد السوڤيتي هي مَن تمكنت أن تصبح حقًا مستقلة. وبعضها قد لا يصل إلى هذه المرحلة، ولذلك أسباب مختلفة، وهو موضوع جدير بالبحث والتحليل، في ظروفٍ أخرى.
في الوقت الحالي، لا يمكنني إلا أن أشير إلى ما هو واضح بالفعل: “معظم النخب المحلية للبلدان المستقلة عن الاتحاد السوڤيتي لا تملك الخبرة التاريخية أو الثقافية لبناء الدولة”. لقد أثبتوا أنهم غير قادرين على أن يشكلوا نواة أمة، ولم يكن لديهم الوقت الكافي لذلك. عندما اختفى الفضاء الفكري والثقافي السوڤيتي المشترك، كانت الدول الصغيرة هي الأكثر تضررًا؛ حيث تبين لها أن الفرص الجديدة لبناء العلاقات مع الغرب ليست بديلًا. كما أن أولئك الذين وجدوا أنفسهم على رأس هذه الدول كانوا يبيعون بلادهم لمصلحتهم الشخصية؛ وذلك لعدم وجود فكرة وطنية يمكن لأحد أن يقاتل من أجلها. وليس أمام هذه الدول إلا أن تحذو حذو دول البلطيق، وذلك من خلال قبول السيطرة الخارجية، أو أن تتجه نحو الفوضى والخروج عن نطاق السيطرة، وهو الأمر الذي قد يكون في بعض الحالات خطيرًا جدًا.
دعونا الآن نترك النقاش عن “التوحيد” الذي يفرضه علينا التاريخ إلى يوم آخر. ولنتحدث هذه المرة عن الحاجة الموضوعية إلى اتخاذ قرار صارم نحو اعتماد سياسة “التدمير البناء”، والتركيز عليها.
المحطات التي مررنا بها
اليوم نشهد بداية العصر الرابع لسياسة روسيا الخارجية: “بدأ العصر الأول في أواخر الثمانينيات، وكان يمثل وقت الضعف والأوهام”. لقد فقدت الأمة آنذاك إرادة القتال، وأراد الناس تصديق دعاية الديمقراطية، وأن الغرب سيأتي وينقذهم. انتهى كل هذا في عام 1999 بعد الموجات الأولى من توسع الناتو، وهو ما اعتبره الروس طعنةً في الظهر، وبخاصةٍ عندما مزق الغرب ما تبقى من يوغوسلاڤيا.
بعد ذلك، بدأت روسيا بالوقوف على ركبتيها، وإعادة بناء نفسها خلسةً وبشكل سري، في الوقت الذي بدت فيه- في الظاهر- ودودة ومتواضعة. إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية (ABM) أشار إلى نيتها استعادة هيمنتها الإستراتيجية؛ لذلك اتخذت روسيا- التي كانت لا تزال مُنكسرة- قرارًا مصيريًا لتطوير أنظمة تسليح قادرة على تحدي التطلعات الأمريكية.
إن خطاب مؤتمر ميونيخ، والحرب الجورجية، وإطلاق عملية إصلاح الجيش التي أجريت وسط أزمة اقتصادية عالمية، أدت إلى نهاية الإمبريالية الليبرالية العالمية الغربية (المصطلح الذي صاغه الخبير البارز في الشؤون الدولية، ريتشارد ساكوا Richard Sakwa). بعد ذلك ظهر هدف جديد لروسيا في مجال السياسة الخارجية؛ وهو أن تصبح- مرة أخرى- قوة عالمية رائدة يمكنها الدفاع عن سيادتها ومصالحها. تبعت ذلك أحداث شبه جزيرة القرم وسوريا، وتبني سياسة الحشود، ومنع الغرب من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، واستبعاد من دخلوا في شراكة مع الغرب على حساب وطنهم من الخدمة العامة، بما في ذلك من خلال الاستخدام البارع لرد الفعل الغربي على تلك التطورات. مع استمرار التوترات في التصاعد، أصبح التقييم العام للاحتفاظ بالعلاقات مع الغرب ينظر إليه على أنه أقل ربحًا بشكلٍ متزايد، وتزامن ذلك مع الصعود المذهل للصين، وتحول علاقتنا مع بكين نحو التحالف الفعلي بدءًا من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبناء محور يتجه نحو الشرق، وما رافقه من أزمة متعددة الأبعاد أحاطت بالغرب، وقد أدى هذا كله إلى تحول كبير في التوازن السياسي والجغرافي الاقتصادي لصالح روسيا. وقد بات هذا الأمر واضحًا بشكل خاص في أوروبا. قبل عقد واحد فقط، كان الاتحاد الأوروبي لا يرى في روسيا سوى ضواحٍ متخلفة، وبلد ضعيف يحاول مواجهة القوى الكبرى في القارة. أما الآن، فهو يحاول- بشكل يائس- التمسك بالاستقلال الجيوسياسي والجيواقتصادي الذي ينزلق من بين أصابعه.
انتهت فترة “العودة إلى العظمة” بين عامي 2017 و2018. بعد ذلك وصلت روسيا إلى مرحلة الاستقرار، مع استمرار عملية التحديث، لكن الاقتصاد الضعيف كان يهدد بفقدان كل هذه الإنجازات. كان الناس (ومنهم أنا) محبطين خوفًا من أن روسيا ستتعرض- مرة أخرى- لعملية “انتزاع الهزيمة من فكي النصر“، لكن تبين أنها كانت فترة أخرى من أجل مزيد من التعزيزات، خاصةً فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية.
الإنذار الذي وجهته روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي نهاية عام 2021، يمثل مطالبتهما بالتوقف عن تطوير البنية التحتية العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، وإيقاف التوسع شرقًا، وهو ما يمثل بداية لعملية “التدمير البناء” لوضع الأساس لنوع جديد من العلاقات بين روسيا والغرب، يختلف عما استقرت عليه في التسعينيات.
قد تعني القدرات العسكرية الروسية، وعودة الشعور بالصلاح الأخلاقي، والدروس المستفادة من أخطاء الماضي، والتحالف الوثيق مع الصين، أن الغرب الذي اختار أداء دور الخصم، سيبدأ في إعادة حساباته بشكل عقلاني، حتى لو لم يكن طوال الوقت. بعد ذلك، في غضون عقد، أو ربما قبل ذلك، آمل أن يتم بناء نظام جديد للأمن والتعاون الدوليين، يشمل منطقة أوراسيا الكبرى بكاملها هذه المرة، وسوف يستند إلى مبادئ الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وليس “القواعد” الأحادية الجانب التي كان الغرب يحاول أن يفرضها على العالم في العقود الأخيرة.
تصحيح الأخطاء
قبل أن أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، اسمحوا لي أن أقول إنني أقدر كثيرًا الدبلوماسية الروسية؛ فلقد كانت أكثر من رائعة في السنوات الخمس والعشرين الماضية. كانت يد موسكو ما زالت ضعيفة، لكنها مع ذلك تمكنت من لعب مباراة رائعة. أولًا، لم تسمح للغرب “بإنهاء” الوضعية الرسمية لروسيا بوصفها دولة عظمى، واحتفظت بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك بترساناتها النووية، ثم حسّنت تدريجيًا مكانتها العالمية من خلال الاستفادة من نقاط ضعف منافسيها، وقوة شركائها. لقد كان بناء صداقة قوية مع الصين إنجازًا كبيرًا. كما أن روسيا تتمتع ببعض المزايا الجيوسياسية التي لم تكن لدى الاتحاد السوڤيتي.
مع ذلك، يجب ألا ننسى الأخطاء التي ارتكبناها حتى لا نكررها. لقد أدى كسلنا وضعفنا وجمودنا البيروقراطي في المساعدة، إلى خلق وإبقاء النظام الجائر وغير المستقر للأمن الأوروبي الذي نعيش فيه اليوم.
تضمن ميثاق باريس لأوروبا الجديدة المَصوغ صياغةً جميلة، الذي تم التوقيع عليه عام 1990، بندًا عن حرية تكوين التجمعات- يمكن للبلدان أن تختار حلفاءها، وهو أمر كان من الممكن أن يكون مستحيلًا بموجب إعلان هلسنكي عام 1975؛ نظرًا إلى أن حلف وارسو كان قائمًا في تلك المرحلة؛ لذا فإن هذا البند يعني أن الناتو سيكون حرًا في التوسع. هذه هي الوثيقة التي لا يزال الجميع يشير إليها حتى في روسيا. ومع ذلك، بالعودة إلى عام 1990 على الأقل، كان الناتو يُعد منظمة “دفاعية”، ولكن بعد ذلك شن معظم أعضائه عددًا من الحملات العسكرية العدوانية ضد ما تبقى من يوغوسلاڤيا، وكذلك في العراق وليبيا.
بعد محادثة من “القلب إلى القلب” مع ليخ ڤاليسا عام 1993، وقع بوريس يلتسين وثيقة تنص على أن روسيا “تتفهم خطة بولندا للانضمام إلى الناتو”. عندما علم أندريه كوزيريڤ، وزير خارجية روسيا آنذاك، بخطط توسع الناتو عام 1994، بدأ بعملية مساومة نيابةً عن روسيا، ودون استشارة الرئيس، وهو ما اعتبره الجانب الآخر علامة على أن روسيا موافقة على المفهوم العام، لأنها كانت تحاول التفاوض على شروط مقبولة. في عام 1995، ضغطت موسكو على “الفرامل”، لكن الأوان كان قد فات- انهار السد، وأزيلت أي تحفظات بشأن جهود التوسيع التي سعى إليها الغرب.
عام 1997، وقعت روسيا، التي كانت ضعيفة اقتصاديًا، وتعتمد كليًا على الغرب، على القانون التأسيسي للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن مع الناتو. كانت موسكو قادرة على إجبار الغرب على تقديم تنازلات معينة، مثل التعهد بعدم نشر وحدات عسكرية كبيرة في الدول التي نالت العضوية حديثًا، وهو التزام كثيرًا ما انتهكه الناتو.
اتفاقية أخرى تم توقيعها للحفاظ على هذه الأراضي خالية من الأسلحة النووية. كانت الولايات المتحدة تريد أن تنأى بنفسها عن أي صراع نووي محتمل في أوروبا قدر الإمكان (على الرغم من رغبات حلفائها)؛ لأنه سيسبب- بلا شك- ضربة نووية ضد أمريكا. في الواقع، أضفت الوثيقة الشرعية على توسع الناتو.
كانت هناك أخطاء أخرى، ليست كبيرة؛ ولكنها مؤلمة جدًا. شاركت روسيا في برنامج الشراكة من أجل السلام (PfP)، الذي كان الهدف الوحيد منه هو جعل الناتو يبدو وكأنه مستعد للاستماع إلى موسكو، لكن الحلف في الواقع كان يستخدم المشروع لتبرير وجوده، وزيادة توسعه المستمر. خطأ آخر مُحبط، ألا وهو مشاركتنا في “مجلس الناتو وروسيا” بعد عدوان يوغوسلاڤيا، حيث كانت الموضوعات التي نُوقشت على هذا المستوى من “المجالس المشتركة” تفتقر بشدة إلى المضمون. كان ينبغي أن تركز على القضية المهمة حقًا، وهي تقييد توسع الحلف، وتعزيز بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. مع الأسف، لم يصل هذا النقاش إلى جدول الأعمال، واستمر المجلس في العمل حتى بعد أن بدأت غالبية أعضاء الناتو الحرب في العراق، ثم ليبيا عام 2011.
من المؤسف جدًا أننا لم نمتلك الجرأة قط لقول ذلك علانية- لقد أصبح الناتو معتديًا بشكل متزايد، حيث ارتكب كثيرًا من جرائم الحرب. قد تكون هذه حقيقة مفهومة لدى كثير من الدوائر السياسية في أوروبا، مثل فنلندا والسويد على سبيل المثال، عندما يفكرون في مزايا الانضمام إلى الحلف في ظل شعاره المعلن بأنه “تحالف دفاع”، ورادع يحتاج إلى مزيد من التعزيز حتى يتمكن من الوقوف في وجه أعداء وهميين. أستطيع أن فهم دوافع أولئك الشركاء الصغار في الغرب، الذين اعتادوا ذلك النظام الذي يسمح للأمريكيين بشراء طاعتهم، ليس فقط عبر الدعم العسكري؛ ولكن أيضًا من خلال توفيرهم بعض النفقات الأمنية من خلال بيع جزء من سيادتهم.. لكن ما الذي نستفيده نحن من هذا النظام؟ خاصةً بعد أن أصبح واضحًا أنه يسعى إلى تصعيد المواجهة على حدودنا الغربية، وفي العالم كله.
كما أن هذا الحلف “الناتو” أصبح يشكل تهديدًا لأعضائه أيضًا؛ ففي حين أنه يدفع نحو المواجهة، فإنه فعليًا لا يضمن الحماية. ليس صحيحًا أن المادة (الخامسة) من معاهدة حلف شمال الأطلسي تستدعي الدفاع الجماعي إذا تعرض أحد الحلفاء للهجوم. لا تذكر هذه المادة أن هذا الأمر مضمون تلقائيًا. إنني على دراية بتاريخ الحلف والمناقشات في أمريكا بشأن إنشائه. كما أعرف حقيقة أن الولايات المتحدة لن تنشر أبدًا أسلحة نووية “لحماية” حلفائها إذا كان هناك صراع مع دولة نووية أخرى. كذلك فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) قد عفا عليها الزمن، وبات يسيطر عليها الناتو والاتحاد الأوروبي اللذان يستخدمان المنظمة لإطالة أمد المواجهة، وفرض القيم والمعايير السياسية للغرب على الجميع. لحسن الحظ، أصبحت هذه السياسة أقل فاعلية. في منتصف عام 2010، أتيحت لي الفرصة للعمل مع فريق من الشخصيات البارزة، تابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (يا له من اسم جذاب!)، كان من المفترض أن يطور تفويضًا جديدًا لمهام عمل المنظمة. مع أنه كانت لديّ شكوك بشأن فاعلية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قبل ذلك، فإن هذه التجربة أقنعتني بأنها مؤسسة مدمرة إلى أبعد الحدود. إنها منظمة قديمة، مهمتها الحفاظ على الأشياء التي عفا عليها الزمن. في التسعينيات كانت أشبه بأداة لدفن أي محاولة قامت بها روسيا، أو غيرها من الدول، لإنشاء نظام أمني أوروبي مشترك. أما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد أعاقت ما يسمى بعملية كورفو (Corfu)، وهي مبادرة الأمن الروسية الجديدة.
عمليًا، تم إخراج جميع مؤسسات الأمم المتحدة من القارة، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن. ذات مرة، كان يُنظر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أنها منظمة مفيدة، من شأنها تعزيز نظام الأمم المتحدة ومبادئها، وهذا ما لم يحدث. أما بالنسبة إلى حلف الناتو، فمن الواضح جدًا ما يجب أن نفعله. نحن بحاجة إلى تقويض الشرعية الأخلاقية والسياسية لهذا الحلف، ورفض أي شراكة مؤسسية معه؛ لأنها تأتي بنتائج عكسية واضحة.
يجب على الجيش فقط الاستمرار في التواصل، ولكن كقناة مساعدة، من شأنها أن تكمل الحوار مع وزارة الدفاع، ووزارات الدفاع في الدول الأوروبية الرائدة. بعد كل شيء، ليست بروكسل هي التي تتخذ قرارات مهمة من الناحية الإستراتيجية. يمكن اعتماد السياسة نفسها عندما يتعلق الأمر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. نعم، هناك فرق بالتأكيد، لأنه مع أن هذه المنظمة مدمرة وعديمة الفائدة، فإنها لم تبدأ أي حروب، أو زعزعة استقرار، أو قتل؛ لذلك نحن بحاجة إلى الحفاظ على مشاركتنا عبر هذا الشكل إلى الحد الأدنى. يقول البعض إن هذا هو السياق الوحيد الذي يمنح وزير الخارجية الروسي فرصة لرؤية نظرائه الأوروبيين. ليس هذا صحيحًا؛ يمكن للأمم المتحدة أن تقدم سياقًا أفضل. تعد المحادثات الثنائية أكثر فاعلية على أي حال؛ لأنه من السهل على أي تحالف أو تكتل أن يفسد جدول الأعمال عندما تكون هناك عدة أطراف. سيكون إرسال مراقبين وقوات حفظ سلام عبر الأمم المتحدة أكثر منطقية.
لا يسمح لي موضوع المقال ومحدوديته بالتفكير في السياسات المحددة التي ينبغي لنا انتهاجها تجاه كل منظمة أوروبية، مثل “مجلس أوروبا”، لكنني سأحدد المبدأ العام بهذه الطريقة: “نشارك حيث نرى فوائد لأنفسنا، ونحافظ على مسافة بيننا”.
أثبتت ثلاثون عامًا في ظل النظام الحالي للمؤسسات الأوروبية أن الاستمرار فيها سيكون ضارًا، ولا تستفيد روسيا منه بأي شكل من الأشكال، خاصةً في ظل نزعة أوروبا نحو تصعيد المواجهة، أو حتى تشكيل تهديد عسكري لشبه القارة، والعالم بأسره. في الماضي، كان بإمكاننا أن نحلم بأن تساعدنا أوروبا على تعزيز الأمن، فضلًا عن التحديث السياسي والاقتصادي. بدلاً من ذلك، هم يقوضون الأمن، فلماذا إذن ننسخ النظام السياسي الغربي المختل وظيفيًا والمتدهور؟ وهل نحتاج حقًا إلى هذه القيم الجديدة التي اعتمدوها؟ يتعين علينا الحد من التوسع؛ من خلال رفض التعاون في إطار نظام متآكل. نأمل، من خلال اتخاذ موقف حازم كهذا، وترك جيراننا “المتحضرين” من الغرب إلى أنظمتهم الخاصة، أن نكون بذلك قد ساعدناهم بالفعل.
قد تعودت النخب الأوروبية ممارسة سياسة انتحارية أقل أمانًا للجميع. بالطبع، يجب أن نكون أذكياء من خلال إخراج أنفسنا من هذه المعادلة، مع التأكد من تقليل الأضرار الجانبية التي سيحدثها هذا النظام الفاشل حتمًا. مع مراعاة أن الحفاظ عليه في شكله الحالي هو- ببساطة- “أمر خطير”.
سياسات لروسيا الغد
مع استمرار النظام العالمي القائم في الانهيار، يبدو أن المسار الأكثر حكمة لروسيا هو البقاء خارجه أطولَ فترةٍ ممكنة، “من خلال الاختباء داخل جدران حصنها الانعزالي الجديد”، والتعامل مع الأمور الداخلية، لكن التاريخ- هذه المرة- يتطلب منا أن نتحرك. إن كثيرًا من اقتراحاتي فيما يتعلق بنهج السياسة الخارجية الذي أسميته مؤقتًا “التدمير البنّاء”، ينبثق- بشكل طبيعي- من التحليل المقدم أعلاه.
ليست هناك حاجة إلى التدخل، أو محاولة التأثير في الديناميكيات الداخلية للغرب، الذي أصبحت نخبته يائسة بما يكفي، حتى إنها باتت مستعدة للدفع إلى بدء حرب باردة جديدة ضد روسيا. ما يجب أن نفعله- بدلًا من ذلك- هو استخدام أدوات السياسة الخارجية المختلفة، بما في ذلك الأدوات العسكرية، لوضع خطوط حمراء معينة. في هذه الأثناء، ومع استمرار النظام الغربي في التوجه نحو التدهور الأخلاقي والسياسي والاقتصادي، ستشهد القوى غير الغربية (مع روسيا كلاعب رئيسي) حتمًا تعزيزًا لمواقفها الجيوسياسية، والجيواقتصادية، والجيوأيديولوجية.
من المتوقع أن يحاول شركاؤنا الغربيون إسكات دعوات روسيا إلى الحصول على ضمانات أمنية، والاستفادة من العملية الدبلوماسية الجارية من أجل إطالة عمر مؤسساتهم. ليست هناك حاجة إلى التخلي عن الحوار، أو التعاون في مسائل التجارة، والسياسة، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية، وما شابه، متى كان ذلك مفيدًا، لكن يجب علينا أيضًا أن نستغل الوقت المتاح لدينا لتكثيف الضغط العسكري- السياسي- النفسي، وحتى العسكري- التقني، ولكن دون أن يتوجه الضغط الأكبر نحو أوكرانيا التي تحول شعبها إلى وقود لمدافع الحرب الباردة الجديدة، ولكن نحو الغرب بشكل جماعي؛ لإجباره على تغيير رأيه، والتراجع عن السياسات التي اتبعها على مدى العقود الكثيرة الماضية. لا يوجد ما نخشاه من تصاعد المواجهة: “لقد رأينا التوترات تتصاعد حتى عندما كانت روسيا تحاول استرضاء العالم الغربي”. ما يجب أن نفعله هو الاستعداد للتصدي للسياسات الغربية بشكل أقوى، كما يجب على روسيا أيضًا أن تكون قادرة على تقديم بديل طويل الأجل للعالم عبر إطار سياسي جديد قائم على السلام والتعاون. بطبيعة الحال، من المفيد تذكير شركائنا الغربيين من وقتٍ إلى آخر، بوجود بديل مفيد لكلا الطرفين.
إذا نفذت روسيا سياسات معقولة، ولكنها حازمة (محليًا أيضًا)، فسوف تتغلب بنجاح (وبشكل سلمي نسبيًا) على أحدث موجة تتعرض لها من العداء الغربي. كما كتبت من قبل، لدينا فرصة جيدة للفوز في هذه الحرب الباردة الجديدة، وما يلهمنا إلى هذا التفاؤل أيضًا هو سجل روسيا السابق: “لقد تمكنا أكثر من مرة من ترويض الطموحات الإمبريالية للقوى الأجنبية لمصلحتنا، ولصالح الإنسانية كلها”. كانت روسيا قادرة على تحويل الإمبراطوريات المحتملة إلى جيران مُروضين وغير مؤذين نسبيًا: “السويد بعد معركة بولتاڤا (1709)، وفرنسا بعد معركة بورودينو (1812)، وألمانيا بعد معركة ستالينغراد (1943)، ومعركة برلين (1945)”.
يمكننا أن نجد شعارًا للسياسة الروسية الجديدة تجاه الغرب عبر مقطع من قصيدة ألكسندر بلوك “السكوثيون”، وهي قصيدة رائعة، تبدو ذات صلة خاصة بأحداث اليوم: “تعالوا وانضموا إلينا، ودعوا عنكم إنذارات الحرب والحرب المضادة، واستمسكوا بالسلام والصداقة؛ لا يزال هناك متسع من الوقت أيها الرفاق، مدّوا أياديكم إلينا لنتحد في أخوة حقيقية!”.
في أثناء محاولتنا معالجة علاقاتنا مع الغرب (حتى لو كان ذلك يتطلب بعض العلاج المر)، يجب أن نتذكر أنه على الرغم من قربنا ثقافيًا منه، فإن العالم الغربي يتلاشى من الوقت: “في الواقع، بدأت هذه العملية منذ عقدين من الزمن”.
يمكن القول إن العلاقات مع الغرب هدفها تقليل الضرر، والتعاون كلما كان ذلك ممكنًا. إن الآفاق والتحديات الحقيقية لحاضرنا ومستقبلنا تكمن في الشرق والجنوب. إن اتخاذ موقف أكثر تشددًا مع الدول الغربية يجب ألا يصرف انتباه روسيا عن الحفاظ على محورها في الشرق. وقد رأينا هذا المحور يتباطأ في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتطوير مناطق خارج جبال الأورال. يجب ألا نسمح لأوكرانيا بأن تصبح تهديدًا أمنيًا لروسيا. بعد قولي هذا سيكون من غير المجدي إنفاق كثير من الموارد الإدارية والسياسية (فضلًا عن الاقتصادية) عليها. يجب أن تتعلم روسيا كيفية إدارة هذا الوضع المتقلب بفاعلية، وإبقائه ضمن حدود السيطرة.
سيكون الاستثمار في الشرق عبر الشروع في عملية تنمية سيبيريا أكثر فاعلية، وذلك من خلال خلق ظروف عمل ومعيشة مواتية. لن نجتذب فقط المواطنين الروس، ولكن أيضًا الأشخاص من الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية الروسية السابقة، بمن في ذلك الأوكرانيون الذين أسهموا تاريخيًا، بقدر كبير، في تطوير سيبيريا.
أرجو أن يسمح لي القراء بتكرار نقطة سبق أن ذكرتها في مقالاتي الأخرى: “لقد كان اندماج سيبيريا تحت حكم إيڤان الرهيب، هو وحده ما جعل روسيا قوة عظمى، وليس انضمام أوكرانيا تحت قيادة أليكسي ميخايلوڤيتش رومانوڤ، المعروف باسم “تيشاتشي”، أي “الأكثر هدوءًا وسلمية”. لقد حان الوقت لأن نتوقف عن تكرار تأكيد ذلك البولندي المخادع زبيغنيو بريجنسكي: “بأن روسيا لا يمكن أن تكون قوة عظمى بدون أوكرانيا”. إن العكس هو الأقرب إلى الحقيقة: “لا يمكن لروسيا أن تكون قوة عظمى عندما تكون مثقلة بأعباء بلد مثل أوكرانيا”، وهي أعباء شديدة الصعوبة لإدارة هذا الكيان السياسي المصطنع الذي أنشأه لينين، والذي توسع لاحقًا غربًا في عهد ستالين.
يكمن المسار الواعد لروسيا في تنمية العلاقات مع الصين وتعزيزها: “من شأن الشراكة مع بكين أن تضاعف إمكانات كلا البلدين عدة مرات”. إذا استمر الغرب في سياساته العدائية المريرة فلن يكون من غير المعقول التفكير في تحالف دفاعي مؤقت لمدة خمس سنوات مع الصين.
بطبيعة الحال، يجب علينا أن نحرص على حماية الصين من “الشعور بالدوار من النجاح”، وذلك حتى لا تعود إلى نموذج الإمبراطورية الصينية في العصور الوسطى، التي نمت ثم حولت جيرانها إلى تابعين. يجب أن نساعد بكين حيثما أمكننا لمنعها من المعاناة حتى من هزيمة مؤقتة في الحرب الباردة الجديدة التي أطلقها الغرب ضدها، هذه الهزيمة ستضعفنا أيضًا. إضافة إلى ذلك، نحن نعلم جيدًا ما الذي يتحول إليه الغرب عندما يعتقد أنه يفوز. لقد تطلب الأمر بعض العلاجات القاسية لعلاج مخلفات أمريكا بعد نشوة النصر وسكرتها بالسلطة في التسعينيات.
من الواضح أن السياسة الموجهة نحو الشرق يجب ألا تركز فقط على الصين. يشهد كل من الشرق والجنوب تصاعدًا في السياسة، والاقتصاد، والثقافة العالمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقويضنا للتفوق العسكري للغرب “المصدر الأساسي لهيمنته على مدى 500 عام”.
عندما يحين الوقت لتأسيس نظام جديد للأمن الأوروبي ليحل محل النظام الحالي الذي عفا عليه الزمن بشكل خطير، يجب أن يتم ذلك في إطار مشروع أوراسيا الكبرى. لا شيء يستحق العناء يمكن أن يولّد هذا النظام الجديد من رحم النظام الأوروبي الأطلسي القديم. من البديهي أن النجاح يتطلب تطوير الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية للبلاد وتحديثها، مع جميع ركائز القوة العسكرية التي تمثل لأي دولة العمود الفقري لسيادتها وأمنها. لا يمكن أن تنجح روسيا دون تحسين نوعية الحياة لغالبية شعبها، “يشمل هذا الازدهار العام، والرعاية الصحية، والتعليم، والبيئة”.
إن تقييد الحريات السياسية، وهو أمر حتمي عند مواجهة الغرب وهو متكتل بشكل جماعي ضدنا، يجب ألا يمتد- بأي حال من الأحوال- إلى المجال الفكري، خاصةً لدى الجزء الموهوب وذي العقلية الإبداعية من السكان المستعدين لخدمة وطنهم. يجب علينا الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحرية الفكرية. التطور العلمي من خلال “شاراشكا” على الطراز السوڤيتي (مختبرات البحث والتطوير التي تعمل ضمن نظام معسكر العمل السوڤيتي) ليس شيئًا من شأنه أن ينجح في العالم الحديث. تعزز الحرية مواهب الشعب الروسي، والابتكار يسري في دمائنا. حتى في السياسة الخارجية، فإن التحرر من القيود الأيديولوجية التي نتمتع بها يوفر لنا مزايا كبيرة مقارنة بجيراننا الأكثر انغلاقًا. يعلمنا التاريخ أن التقييد الوحشي لحرية الفكر، الذي فرضه النظام الشيوعي على شعبه، أدى إلى خراب الاتحاد السوڤيتي. الحفاظ على الحرية الشخصية شرط أساسي لتنمية أي أمة.
إذا أردنا أن ننمو كمجتمع وننتصر، فمن الأهمية بمكان أن نطور العمود الفقري الروحي لبلادنا؛ “من خلال إطلاق فكرة وطنية أيديولوجية توحد وتضيء لنا الطريق إلى الأمام”. إنها حقيقة أساسية مفادها أن الدول العظيمة لا يمكن أن تكون عظيمة حقًا بدون وجود هذه الفكرة في صميمها. هذا جزء من المأساة التي حدثت لنا في السبعينيات والثمانينيات. نأمل أن تبدأ النخب الحاكمة بعدم معارضة تقديم أيديولوجيا جديدة، والتخلي عن الخوف من الأيديولوجيا المتجذرة بسبب آلام الحقبة الشيوعية. كان خطاب ڤلاديمير پوتين، في الاجتماع السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لنادي ڤالداي للحوار، إشارة مطمئنة في هذا الصدد. مثل العدد المتزايد باستمرار من الفلاسفة والمؤلفين الروس، طرحت رؤيتي الخاصة “لـلفكرة الروسية”، التي لا يتسع المقال لذكرها.
أسئلة للمستقبل
والآن دعونا نناقش جانبًا مهمًا، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله من السياسة الجديدة، غير أنه يحتاج إلى معالجة. نحن بحاجة إلى رفض إصلاح الأساس الأيديولوجي المتقادم، الذي غالبًا ما يكون ضارًا لعلومنا الاجتماعية، والحياة العامة. ولكي يتم تنفيذ هذه السياسة الجديدة، فضلًا عن النجاح،
فإن هذا لا يعني أن علينا أن نرفض- مرة أخرى- التطورات في العلوم السياسية، والاقتصاد، والشؤون الخارجية لأسلافنا. حاول البلاشفة التخلص من الأفكار الاجتماعية لروسيا القيصرية، والجميع يعرف كيف حدث ذلك.
لقد رفضنا الماركسية، ولكن ما زال لدى ماركس وإنجلز ولينين أفكار سليمة في نظريتهم عن الإمبريالية التي يمكننا استخدامها. العلوم الاجتماعية التي تدرس طرق الحياة العامة والخاصة يجب أن تأخذ الحُسبان السياق الوطني، وأن يكون لديها منهج شامل ينبع من التاريخ الوطني، ويهدف- في النهاية- إلى مساعدة الأمة، وحكومتها، ونخبها. إن التطبيق الطائش للحلول الصالحة في بلد ما، في بلد آخر، أمر لا طائل من ورائه، ولا يؤدي إلا إلى الفظائع.
نحتاج أن نبدأ العمل نحو الاستقلال الفكري بعد أن نحقق الأمن العسكري، والسيادة السياسية والاقتصادية. في العالم الجديد، من الضروري تحقيق التنمية، وممارسة التأثير. كان ميخائيل ريميزوڤ (Mikhail Remizov)، وهو عالم سياسي روسي بارز، أول من أطلق- حسب علمي- مصطلح “إنهاء الاستعمار الفكري”. بعد أن أمضينا عقودًا في ظل الماركسية المستوردة، بدأنا بالانتقال إلى أيديولوجيا أجنبية أخرى، مثل الديمقراطية الليبرالية في الاقتصاد والعلوم السياسية، وإلى حد معين حتى في السياسة الخارجية، والدفاع. لم ينفعنا هذا السحر “الجديد”، فقد خسرنا الأرض، والتكنولوجيا، والمجتمع. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأنا بممارسة سيادتنا، لكن كان علينا الاعتماد على غرائزنا بدلًا من المبادئ العلمية والأيديولوجية الواضحة (مرة أخرى، لا يمكن أن نتوقع- في ظل هذه الظروف- شيئًا آخر).
لتوضيح هذه النقطة، إليك بعض الأسئلة المختارة عشوائيًا من قائمتي الطويلة جدًا:
سأبدأ بقضايا وجودية فلسفية بحتة:
ما الذي يأتي أولاً ويؤثر في الإنسان؟ الروح أم المادة؟ وبمعنى سياسي أكثر دنيوية: ما الدافع الرئيسي للناس والدول في العالم الحديث؟ بالنسبة إلى عامة الماركسيين والليبراليين، الجواب هو الاقتصاد. فقط تذكر أنه حتى وقت قريب، كان يُعتقد أن عبارة “إنه الاقتصاد يا غبي”، الشهيرة لبيل كلينتون، كانت بديهية، لكن الناس يبحثون عن شيء أكبر عندما تُشبَع الحاجة الأساسية للطعام، حبهم لأسرهم ووطنهم، ورغبتهم في الكرامة الوطنية، والحريات الشخصية، والسلطة، والشهرة. لقد عرفنا التسلسل الهرمي للاحتياجات منذ أن قدمه ماسلو، في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته، في هرمه الشهير، غير أن الرأسمالية الحديثة أفسدته، وتم التسويق لثقافة الاستهلاك باستمرار، وبشكل متزايد، عبر الوسائط التقليدية في البداية، والشبكات الرقمية الشاملة لاحقًا الأثرياء والفقراء، كل حسب قدرته.
ماذا يمكننا أن نفعل عندما تحرض الرأسمالية الحديثة، المجردة من الأسس الأخلاقية أو الدينية، على الاستهلاك غير المحدود، وتكسر الحدود الأخلاقية والجغرافية، وتتعارض مع الطبيعة، وتهدد وجود جنسنا البشري ذاته؟
نحن الروس، نفهم أفضل من أي شخص آخر، أن التخلص من رواد الأعمال والرأسماليين الذين تحركهم الرغبة في بناء الثروة، ستكون له عواقب وخيمة على الناس، وبيئة المجتمع (لم يكن نموذج الاقتصاد الاشتراكي صديقًا للبيئة تمامًا).
ماذا نفعل بالقيم “الحديثة” التي تدعو إلى رفض تاريخك، ووطنك، وجنسك، ومعتقداتك، بالإضافة إلى الدعاية العدوانية لما يسمى مجتمع الميم (LGBT)، والحركات النسوية المتطرفة؟ أنا أحترم حق كل فرد في اتباع ما يريد، لكنني أعتقد أنهم ما بعد إنسانيين. هل يجب أن نتعامل مع هذا على أنه مجرد مرحلة أخرى من التطور الاجتماعي؟ لا أعتقد ذلك. هل يجب أن نحاول درء خطره، والحد من انتشاره، أم الانتظار حتى يعيش المجتمع داخل هذا الوباء الأخلاقي؟ أم يجب علينا محاربة تلك القيم “الحديثة” بنشاط، وقيادة غالبية البشرية التي تتمسك بما يسمى بالقيم “المحافظة”، أو ببساطة، القيم الإنسانية العادية؟ هل يجب أن ندخل في القتال لتصعيد المواجهة الخطيرة بالفعل مع النخب الغربية؟
ساعد التطور التكنولوجي وزيادة إنتاجية العمل على إطعام غالبية الناس، لكن العالم نفسه انزلق إلى الفوضى، وفقد كثيرًا من المبادئ التوجيهية على المستوى العالمي. ربما تسود المخاوف الأمنية على الاقتصاد مرة أخرى. قد تأخذ الأدوات العسكرية والإرادة السياسية زمام المبادرة من الآن فصاعدًا.
ما الردع العسكري في العالم الحديث؟ هل يتمثل التهديد في إلحاق الضرر بالأصول الوطنية والفردية، أو الأصول الأجنبية، والبنية التحتية للمعلومات التي ترتبط بها النخب الغربية اليوم ارتباطًا وثيقًا؟ ماذا سيحدث للعالم الغربي إذا انهارت هذه البنية التحتية؟
سؤال آخر ذو صلة: ما التكافؤ الإستراتيجي الذي ما زلنا نتحدث عنه اليوم؟ هل هو نوع من الهراء الفكري المستورد من الخارج الذي اختاره القادة السوڤيت الذين أدخلوا شعبهم في سباق تسلح مرهق بسبب عقدة النقص لديهم، النابعة من متلازمة 22 يونيو (حزيران) 1941؟
يبدو أننا نجيب بالفعل عن هذا السؤال، مع أننا ما زلنا نطلق الخطب عن المساواة والمقاييس المتكافئة- ما الحد من التسلح الذي يعتقد الكثيرون أنه مفيد؟ هل هو محاولة لكبح سباق التسلح المكلف الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الأكثر ثراءً للحد من أخطار الأعمال العدائية، أو شيء آخر، مثل أداة لإضفاء الشرعية على سباق الأسلحة وتطويرها، وعملية الإنفاق غير الضرورية على خصمك؟ لا توجد إجابة واضحة عن ذلك.
لكن دعونا نَعُد إلى الأسئلة الأكثر وجودية:
هل الديمقراطية حقًا هي قمة التطور السياسي؟ أم مجرد أداة أخرى تساعد النخب على السيطرة على المجتمع، إذا لم نتحدث عن ديمقراطية أرسطو النقية (التي لها أيضًا قيود معينة)؟
هناك كثير من الأدوات التي تأتي وتذهب مع تغير المجتمع والظروف. في بعض الأحيان نتخلى عنها فقط لاستعادتها عندما يحين الوقت، ويكون هناك طلب خارجي وداخلي عليها. أنا لا أدعو إلى سلطوية لا حدود لها أو ملكية. أعتقد أننا قد بالغنا بالفعل في المركزية، خاصةً على مستوى الحكومة المحلية. لكن إذا كانت هذه مجرد أداة، ألا يجب أن نتوقف عن التظاهر بأننا نسعى جاهدين من أجل الديمقراطية ونضعها في نصابها الصحيح؟ نريد الحريات الشخصية، ومجتمعًا مزدهرًا، وأمنًا، وكرامة وطنية؟ لكن كيف نبرر للناس استخدام القوة إذن؟
هل الدولة مقدر حقًا لها أن تموت كما اعتاد الماركسيون ودعاة العولمة الليبراليون الاعتقاد، أو كما كانوا يحلمون بتحالفات بين الشركات غير الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية (كلتاهما كانت تمر بالتأميم والخصخصة)، والهيئات السياسية فوق الوطنية؟ سنرى إلى متى يمكن للاتحاد الأوروبي البقاء في شكله الحالي. هل نسعى إلى إزالة الحواجز الجمركية الباهظة الثمن، أو تقديم سياسات بيئية مشتركة، أم سيكون من الأفضل التركيز على تطوير دولتك، ودعم جيرانك، مع تجاهل المشكلات العالمية التي يخلقها الآخرون؟
ما دور الأراضي والمناطق؟ هل هي أصول متضائلة، فقط مجرد عبء كما اعتقد علماء السياسة مؤخرًا؟ أم أعظم ثروة وطنية، خاصة في مواجهة الأزمة البيئية، والتغير المناخي، وتزايد عجز المياه والغذاء في بعض المناطق، وغيابها التام في مناطق أخرى؟
ماذا يجب أن نفعل بعد ذلك بمئات الملايين من الباكستانيين والهنود والعرب، وغيرهم ممن قد تصبح أراضيهم غير صالحة للسكن قريبًا؟ هل يجب أن ندعوهم الآن كما بدأت الولايات المتحدة وأوروبا في الستينيات بجذب المهاجرين لخفض تكلفة العمالة المحلية، وتقويض النقابات العمالية؟ أم يجب أن نستعد للدفاع عن أراضينا من الغرباء؟ في هذه الحالة، يجب أن نتخلى عن كل أمل في تطوير الديمقراطية، كما تظهر تجربة إسرائيل مع سكانها العرب.
هل سيساعد تطوير “الروبوتات” على تعويض نقص القوى العاملة، وجعل تلك المناطق قابلة للعيش مرة أخرى؟ ما دور السكان الأصليين الروس في بلدنا، مع الأخذ في الحُسبان أن عددهم سيتقلص حتمًا؟ بالنظر إلى أن الروس كانوا تاريخيًا شعبًا منفتحًا، فقد تكون الآفاق متفائلة، لكن الأمر غير واضح حتى الآن.
يمكنني المضي قدمًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. يجب طرح هذه الأسئلة، ومن الضروري العثور على إجابات في أقرب وقت ممكن؛ من أجل النمو والظهور في المقدمة. تحتاج روسيا إلى اقتصاد سياسي جديد، خالٍ من العقائد الماركسية والليبرالية، ولكنه يملك أيضًا شيئًا أكثر من البراغماتية الحالية التي تستند إليها سياستنا الخارجية. يجب أن تتضمن المثالية الموجهة إلى الأمام أيديولوجيا روسية جديدة تدمج معها تاريخنا وتقاليدنا الفلسفية. هذا يعكس الأفكار التي طرحها الأكاديمي باڤل تسيغانكوڤ (Pavel Tsygankov).
أعتقد أن هذا هو الهدف النهائي لجميع أبحاثنا في الشؤون الخارجية، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والفلسفة. هذه المهمة كبيرة، وأكثر من كونها صعبة. لا يمكننا الاستمرار في المساهمة في مجتمعنا وبلدنا إلا من خلال كسر أنماط تفكيرنا القديمة. ولكن في الختام، بملاحظة متفائلة، إليك فكرة فكاهية: “ألم يحن الوقت للاعتراف بأن موضوع دراستنا- الشؤون الخارجية، والسياسات الداخلية، والاقتصاد- هو نتيجة عملية إبداعية يشارك فيها الجماهير والقادة على حدٍ سواء؟ أم إنه- بطريقةٍ ما- فن، إلى حد كبير، يتحدى التفسير، وينبع من الحدس والموهبة؟ ولذا فنحن مثل خبراء الفن: “نتحدث عنه، ونحدد الاتجاهات، ونعلم الفنانين، وهم في حالتنا الجماهير والقادة– التاريخ، وهو أمر مفيد لهم. غالبًا ما نغرق في الجانب النظري، ونخرج بأفكار منفصلة عن الواقع، أو نشوهها من خلال التركيز على أجزاء منفصلة، ولكننا أحيانًا نصنع التاريخ: “فكر في يفغيني بريماكوف، أو هنري كيسنجر”.
لكنني أزعم أنهم لم يهتموا بمقاربات تاريخ الفن الذي يمثلونه. لقد استندوا إلى معرفتهم، وخبرتهم الشخصية، ومبادئهم الأخلاقية، وحدسهم. تعجبني فكرة كوننا نوعًا من الخبراء في الفن، وأعتقد أنه يمكن أن يجعل تلك المهمة الشاقة لمراجعة بعض العقائد الراسخة أسهل قليلًا.[1]
ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز الدراسات العربية الأوراسية
———————-
الغزو الرّوسي ومحور “أبو شحاطة”/ د.مكرم رباح
بعد مرور أسبوع وأكثر على بدء الغزو الروسي، أو بالأحرى البوتيني لأوكرانيا، تفاجأ العالم بحقائق عديدة، منها سياسية ومنها عسكرية، تقودنا إلى استنتاجات يتبين فيها أن الجيش الروسي “الرهيب” وجوهرة تاج محور الممانعة هو في آخر المطاف جيش بائس لا ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين، وهو كحليفه الجيش السوري بقيادة آل الأسد “جيش أبو شحاطة” (الشبشب)، يمتهن الدمار و”التعفيش” أي سرقة المدنيين.
التشبيه بطبيعة الحال لا يشمل الجنود والشعبين الروسي والسوري، بل يخاطب العقلية التابعة لقيادتهم السياسية، التي تدّعي التطور، فيما هي قمة في الوضاعة التقنية والأخلاقية.
منذ انتهاء الحرب العالمية وثم الباردة، لم يواجه الجيش الروسي، أو حتى سلفه السوفياتي، أي جيش غربي حديث، بل اكتفى بعرض عضلاته في قمع الثورات المتنقلة داخل الجمهوريات السوفياتية السابقة، وتسليح البلدان الحليفة والتابعة له كمجموعة الدول العربية المتمثلة بمصر والعراق وسوريا، والتي فشلت بالمجمل – بسبب غياب التدريب والعناصر البشرية الجيدة – في استعمال الأسلحة السوفياتية في مواجهة دولة إسرائيل التي حصلت على الأسلحة الغربية المتطورة، والأهم أنها نجحت في استعمالها.
غزو بوتين أوكرانيا أعاد تأكيد المؤكد، وهو عدم استيعاب هذا الطاغية مفهوم القوى العظمى في وسط عالم متغير. فالقوة الحقيقية ليست بعدد الرؤوس النووية ولا بالدبابات والآليات المدرعة والجيوش الجرارة؛ بل القوة الحقيقية هي في قدرة الدول على شن الحروب الاقتصادية والعسكرية من دون تدمير الاقتصاد العائد لها، وهي حقيقة غابت عن ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهووس بصورته السلطوية.
لعل السخرية الحقيقية بأن “القيصر” بوتين الذي يحرص على أخذ الصور وهو شبه عار على صهوة جواد، أو يلعب رياضة الجودو والهوكي على الجليد، قد صفعه الشعب الأوكراني ورئيسه فولوديمير زيلينسكي، الكوميدي والممثل السابق، الذي أصبح مثالاً للمقاومة الشعبية القادرة على تعبئة الرأي العام في خدمة الدفاع عن الأرض والحرية.
منظر الجيش الروسي المتعثر وهو يحاول تحقيق أهداف بوتين في تدمير أوكرانيا محزن ومفرح في الوقت نفسه، فالرغبة الجامحة بالنصر السريع أنست بوتين وضع الجيش الروسي، وعدم قدرته على شن غزو بري واسع بهذا الحجم. وليظهر أن الهجوم جاء من دون خطوط إمداد تؤمن المحروقات والغذاء للجيش الجرار. خطوة حوّلت خصمه الأوكراني نحو المقاومة الشعبية المجهزة بأسلحة مناسبة، ربما ليست كافية لتدمير بوتين، ولكنها نجحت بلا شك في تلقين قواته درساً في التواضع.
بوتين وحلفاؤه الإيرانيون وآل الأسد اعتبروا الحرب على الشعب السوري غير المجهز إنجازاً عسكرياً، وأن طائراتهم التي يعود تاريخ تصنيعها إلى زمن الحرب الباردة وبراميلهم المتفجرة على رؤوس الأطفال والمدنيين قادرة على كتابة سيناريو جديد على الأرض الأوكرانية.
ولكن الفرق في أوكرانيا، أن أوروبا القديمة قررت الانتفاض بدل الانقسام، ليس فقط لنصرة الشعب الأوكراني، بل لمعرفتها أن صمتها عن الغزو الروسي الآن سيسمح لبوتين بغزوها لاحقاً.
بتسرعه وغروره نجح بوتين في تغيير أوروبا من “العجوز النائم” والمنقسم إلى قارة تدافع عن أمنها السياسي والاقتصادي، وترفض السماح لـ”دكتاتور” قابع في موسكو بتغيير نبض حياتها الحر والديموقراطي.
هذا الغزو دفع ألمانيا نحو بناء جيش هجومي، وهي التي ألقت السلاح بعد التخلص من هتلر، كذلك دفعت بلدانا كفنلندا والسويد إلى عدم التراجع أمام تهديدات بوتين.
التعثر المرحلي ولربما الخسارة الروسية المستمرة ليسا فقط بسبب المليار دولار من المساعدات الأميركية العسكرية التي تلقتها أوكرانيا، بل بسبب الدعم الدولي والأوروبي للشعب الأوكراني. فسويسرا كسرت حيادها التاريخي لتدين بوتين، وهولندا والسويد وفنلندا ودول أخرى هرعت الى نجدة أوكرانيا، حتى تركيا و”سلطانها” المزعوم رجب طيب أردوغان أرسلا المسيرة “بيرقدار” التي توثق تدمير جيش بوتين وتعطي المدفعية الأوكرانية القدرة على تدمير الرتل الروسي المتجه نحو العاصمة كييف.
وكما ظهر فإن بوتين ومحور “أبو شحاطة” يدّعيان القوة العظمى، فيما الجيش الروسي في الميدان لا يملك القدرة على القتال في الليل، ولا آلياته العسكرية وجنوده مجهزون بنظام تحديد المواقع GPS-ودبابتهم وطائراتهم تحولت الى أهداف سهلة لمزيج من المنظومات المضادة للدروع والدفاعات الجوية التي أصبحت في يد المقاومين الأوكران.
العظمة الحقيقة في زمننا هذا هي لثقافة السلام والمحبة، مرحلة يستطيع فيها القائد معانقة أم وزوجة وابنة شهيد، والنظر في عيونهن، والاعتذار عن إرسال حبيب إلى ساحة المعركة، وليس الموت العبثي الذي يرسل فيه جنوده بطعام منتهي الصلاحية، وإجبارهم على اللجوء للسرقة والنهب للبقاء أحياء.
بوتين و”محور أبو شحاطة” ومناصروهم في أصقاع الأرض لم يصلوا إلى هذا المستوى من الإنسانية، بل هم يعتبرون الخوف والرعب أسمى من كرامة الإنسان.
يمكن للأيام المقبلة أن تشهد سقوط العاصمة الأوكرانية كييف، أو أن تصمد طويلاً وتعلّم “الجيش الجرار” معنى الحرية والإنسانية، ولكن المؤكد أن العالم دخل مرحلة جديدة ولا مكان فيه لنفسية “الشحاطة”.
النهار العربي
————–
عبر واشنطن بوست.. ضابط سوري منشق يقدم النصح للأوكرانيين في حربهم ضد الروس
أورينت نت – إعداد: ياسين أبو فاضل
مستلهماً من التجربة السورية، وجّه الضابط المنشق، عبد الجبار العكيدي مجموعة نصائح للأوكرانيين من أجل مساعدتهم في التصدي للغزو الروسي.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الثلاثاء مقال رأي للكاتب جوش روجين تناول الصراع في أوكرانيا، حيث استعان الكاتب بخبرة الضابط السوري المنشق عبد الجبار العكيدي لتقديم النصح للأوكرانيين حول طرق مواجهة الهجوم الروسي.
ونقل المقال عن العكيدي قوله “بادئ ذي بدء، أود أن أقول إن الإخوة والأخوات الأوكرانيين لا ينتظرون النصيحة حالياً بل الدعم من دول الغرب.. لكن لبدء نصيحتي، أود أن أقول عدم الاعتماد على المجتمع الدولي، وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة، لأنهم أعطوا بوتين شيكاً على بياض ويداً مفتوحة في سوريا.”
وقال العكيدي “لقد مرت سبع سنوات من التدريب المكثف بالذخيرة الحية ومختلف أنواع الأسلحة والطائرات ضد أهداف حية، بما في ذلك الأطفال وقد سمحت الولايات المتحدة وأوروبا لروسيا بالقتل بلا هوادة في سوريا بكل أنواع الأسلحة، والعالم الآن يدفع ثمن ذلك في أوكرانيا”.
وأضاف العكيدي إنه عندما لا يتمكن بوتين من تحقيق أهدافه العسكرية بالقوات التقليدية، فسوف لن يدخر سلاحاً لاستخدامه ضد الأبرياء، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وسوف يفعل بوتين أي شيء لكسر إرادة الشعب.
واعتبر أن الأوكرانيين لديهم أفضلية واضحة، تتمثل في أنهم يقاتلون من أجل شيء عزيز عليهم كمنازلهم وعائلاتهم، وعلى دراية أكثر بأراضيهم، أما الجنود الروس فليس لديهم معنويات لأنهم ليس لديهم دافع حقيقي.
وأعرب العكيدي عن اعتقاده بأن الطريقة الأكثر فعالية لصدّ التقدم الروسي هي نشر صواريخ ستينغر المضادة للطائرات على نطاق واسع، وكذلك أنظمة مضادة للدبابات ومضادة للدروع.
وقال: “عندما تسقط طائرتان في مكان معين، فأنت تعلم أنه يمكنك العمل بحرية أكبر في ذلك المكان، لأنهم سيخشون التحليق فوقه، وهذا أمر ضروري حقاً”.
ورأى العكيدي أن الانتصار على روسيا يعني ببساطة استمرار المقاومة ضد غزو قواتها، وجعل بوتين يدفع ثمناً أعلى لعدوانه، من خلال القتال والصمود.
واختتم إفادته مخاطباً الأوكرانيين “فقط اعلموا أنكم أقوى مما يعتقده الناس تجمعوا معاً وقاتلوهم لأطول فترة ممكنة… نحن نؤمن بكم، نحن ندعو من أجلكم كي تصمدوا”.
—————————
روسيا لن تجلس في آخر الحافلة بعد الآن!/ كاثي بويد
ترجمة منى فرح
تعتبر الصحافية الأميركية كاثي بويد (مقيمة في كندا) في مقالة لها في موقع The Unz Review أن التوغل الروسي في أوكرانيا نتيجة مباشرة ومتراكمة للأعمال التي دبرتها الولايات المتحدة على مدى ثلاثين عاماً، من أجل “وضع روسيا في الجزء الخلفي من الحافلة”. منذ سقوط النظام الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفيتي (1989-1991)، سعى صقور السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، إلى اتباع “منهج”- أطلق عليه المحلل الراحل في قناة “فوكس نيوز”، تشارلز كراوثامر، مصطلح “عالم أحادي القطب”. كان كراوثامر يعني بذلك عالم ما بعد الشيوعية. وعلى حد تعبير المؤلف البارز آلان بلوم (من المحافظين الجُدد): “عندما نتحدث؛ نحن الأميركيين؛ بجدية عن السياسة، فإننا نعني أن مبادئ الحرية والمساواة والحقوق المبنية عليهما منطقية وقابلة للتطبيق في كل مكان. لقد كانت الحرب العالمية الثانية تجربة تعليمية تم إجراؤها لإجبار أولئك الذين لا يقبلون هذه المبادئ على أن يقبلوا بها من دون جدال”. الأوليغارشية تسيطر وتحكم لكن، في الواقع، وكما أوضح الكاتب الأميركي الراحل صموئيل ت. فرانسيس في العديد من الكتب والمقالات التي نشرها (وخصوصاً كتابه الرائع “ليفياثان وأعداؤه” Leviathan and Its Enemies حول النظرية السياسية وتاريخ العالم الحديث)، فإن رؤية المحافظين الجُدد لنظام عالمي جديد “ليست سوى شكلاً من أشكال حكم الكليبتوقراطية (الأوليغارشية) الإدارية”. فالنُخب القوية تسيطر على حكومتنا (العتيدة) وتفرض إرادتها داخل الشركات الكبرى. هؤلاء يتبجحون دائماً بالديموقراطية، بينما هم في الواقع يستخدمون هذا المصطلح (الديموقراطية) لإخفاء هيمنتهم المتزايدة على كل جوانب الحياة العامة والخاصة، سواء في الولايات المتحدة، أو أوروبا الغربية، أو في معظم الكتلة الشرقية السابقة (منذ 1991). الأزمة الأوكرانية سببتها أهداف ومناورات “الأوليغارشية” الأميركية، ومحاولاتها وضع روسيا في الجزء الخلفي من الحافلة هل نحتاج إلى مزيد من الأمثلة غير تلك التي تحدث بالقرب منا، مثل الإجراءات الاستبدادية الأخيرة التي مارسها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أو الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها ما يسمى بشكل ملطف “لجنة 6 كانون الثاني/يناير” في الكونغرس الأميركي؟ حاول أن تقف في طريق المديرين الإداريين في الدولة العميقة، وستتعرض فوراً للقمع والإلغاء والاعتقال والاحتجاز في سجن فيدرالي لأشهر دون كفالة أو محاكمة. إن الأزمة الحالية في أوكرانيا لها علاقة بأهداف ومناورات هذه “الأوليغارشية” الإدارية، ومحاولاتها إجبار روسيا ما بعد الشيوعية – المعادية للماركسية – على قبول مثل هذا النموذج. لنستعيد شيئاً من التاريخ: الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف ووزير الخارجية جيمس بيكر (ممثلاً للرئيس جورج بوش الأب) اتفقا رسمياً من حيث المبدأ على أن الاتحاد السوفيتي القديم سوف يتفكك إلى “جمهوريات” متعددة ومختلفة، في مقابل أن يلتزم حلف “الناتو” بعدم التوسع إلى ما وراء حدوده الحالية (آنذاك). أي أن يتعهد “الناتو” بعدم إتخاذ أي إجراء يمكن اعتباره معادياً ومهيناً بشكل مباشر لاتحاد روسي مُقلص إلى حد كبير في أي من بلدان الكتلة الشرقية السابقة (بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ودول البلطيق، على سبيل المثال). في الواقع، بعد نهاية الاتحاد السوفيتي، وتقطيع أوصاله، وصعود شخصية تقليدية ومؤيدة للمسيحية إلى مركز القيادة في موسكو (تشبه شخصة القس فرانكلين غراهام)، هل كان هناك من سبب لوجود حلف شمالي الأطلسي “بخلاف أنه وسيلة لاستمرار وزيادة الرقابة والهيمنة”، كما أمل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ذات مرة، وكما نظَّر آلان بلوم دائماً؟ في دراسته الممتازة والمفصلة جداً، نشرها في كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعنوان “أوكرانيا خط المواجهة: أزمة في الأراضي الحدودية”، وصف البروفيسور ريتشارد ساكوا (من جامعة “كنت” البريطانية) ما حدث بعد سقوط الشيوعية السوفييتية بانتصار “عدم التماثل”، وهو ما يعني أنه بدلاً من الترحيب بروسيا الجديدة (ما بعد الشيوعية)؛ التي أكدت رفضها وتخليها بشكل علني عن سبعين عاماً من الهيمنة الماركسية؛ كشريك متساوٍ في “الغرب الأكبر”، عمد صانعو السياسة الخارجية وقادة تيار المحافظين الجُدد في كل من واشنطن وبروكسل إلى مطالبة روسيا بالتخلي عن أي إدعاء بأي استقلال حقيقي أو المطالبة بأي نوع من الشراكة الحقيقية مع الغرب. ليس هناك ما يبرر وجود “الناتو” اليوم بخلاف أنه وسيلة لاستمرار وزيادة الرقابة والهيمنة الأميركية حدث ذلك على مراحل، ففي كل مرة كان يُعقد فيها اتفاقيات أو بروتوكولات أو مُذكرات تفاهم رسمية بين الأطراف، كان يتم تقويضها بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة أو من قبل النظام الموالي في كييف. منذ فترة إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، واستمراراً حتى عام 2020، تم إستجرار دول الكتلة الشرقية السابقة؛ الواحدة تلو الأخرى؛ إلى عضوية حلف “الناتو”، بما في ذلك دول البلطيق. وهذا يعني في الواقع أن “وعود بيكر- بوش الأب” كانت فارغة. فماذا كان على الروس أن يفكروا إذن؟ اتفاقيات ومعاهدات لم تُفعل لقد قيل الكثير عن “مذكرة بودابست”؛ بشأن الضمانات الأمنية المؤرخة في 5 كانون الأول/ديسمبر 1994. فمن خلال هذه الإتفاقية السياسية أكدت كلٌ من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا إعترافها بأن “بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا أصبحوا أطرافاً ممثلين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبأن هذه الدول قبلت التخلي، وبشكل فعَّال، عن ترساناتها النووية لصالح روسيا”. في المقابل، اعترفت روسيا بسلامة وسيادة أوكرانيا المحايدة، غير العسكرية، وغير المعادية. واشنطن لم تعتبر؛ في أي وقت من الأوقات؛ أن مذكرة بودابست مُلزمة قانونياً، أو حتى من ضمن فئة المعاهدات المُبرَمَة وبناءً على ذلك تم عقد إتفاقية بودابست، وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والصراع الداخلي داخل الدولة الأوكرانية، من عام 1994 حتى الثورة العنيفة التي رعتها واشنطن في ميدان ثورة شباط/ فبراير 2014 (راجع ما كشفت عنه مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند عن تورط بلادها ومشاركتها في تلك الأحداث)، تم إلغاء هذه الإتفاقية فعلياً بسبب الانتهاكات الصارخة من قبل منظمي الاحتجاجات في كييف (الذين تلقوا من واشنطن أكثر من 5 مليارات دولار لإثارة الثورة) وكذلك من قبل الحكومة المنتخبة شعبياً برئاسة فيكتور يانوكوفيتش (الذي اعتبره ثوار أوكرانيا موالٍ لروسيا)، ولاحقاً الإستيلاء على السلطة من قبل “الوحدويين” الأوكرانيين المدعومين من الولايات المتحدة، الذين شرعوا بعد ذلك في ممارسة الاضطهاد والتمييز ضد الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا. تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن واشنطن لم تعتبر؛ في أي وقت من الأوقات؛ أن مذكرة بودابست مُلزمة قانونياً، أو حتى من ضمن فئة المعاهدات المُبرَمَة (بيان 12 نيسان/أبريل 2013). ردَّت روسيا بالانضمام إلى التصويت الساحق لمواطني شبه جزيرة القرم، والتي لم تكن أبداً أوكرانية؛ فقط “أعطيت” بقوة لـ”الجمهورية الاشتراكية الأوكرانية” المصطنعة في عام 1954 من قبل الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف (يُزعم أنه فعل ذلك بعد ليلة من الشرب الصاخب). أما بالنسبة لشبه جزيرة القرم، التي تضم القاعدة البحرية الروسية الرئيسية في البحر الأسود في سيفاستوبول، فيُفترض أنها مضمونة بموجب اتفاق مع روسيا. ولكن بعد “انقلاب مَيدان” (أو “ثورة الميدان الأوروبي”، أو “الانقلاب الأوكراني”)، هدَّد النظام الجديد في كييف، الذي ترعاه واشنطن الآن، بالاستيلاء على الجزيرة. في مؤتمر صحفي عقده في 4 آذار/مارس 2014، ردَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول ما إذا كان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يُعد إنتهاكاً لمذكرة بودابست، وما إذا كان ما يعتبر ما يجري في أوكرانيا “ثورة”، بالقول: “نشأت دولة جديدة، لكننا لم نوقع أي مستندات إلزامية مع هذه الدولة. الدولة الأوكرانية التي كانت متوخاة في مذكرة بودابست لم تعد موجودة فعلياً (…) لقد فرضت وكالات المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية مكانها دولة أخرى، وبالقوة”. يأتي التوغل الروسي في أوكرانيا اليوم كنتيجة مباشرة ومتراكمة للأعمال التي دبرتها وزارة خارجيتنا (الأميركية) ومجتمع استخباراتنا، مع أتباعهم في أوروبا الغربية، على مدى ثلاثين عاماً، من أجل “وضع روسيا في مكانها- في الجزء الخلفي من الحافلة” علاوة على ذلك، أعلنت روسيا أنها لم تكن ملزمة أبداً بـ”إجبار أي جزء من السكان المدنيين الأوكرانيين على البقاء في أوكرانيا ضد إرادتهم”، بما في ذلك الدولتين المستقلتين حديثاً؛ ذات الأغلبية الروسية دونيتسك ولوغانسك. تلك المقاطعات في شرق أوكرانيا، مثل شبه جزيرة القرم، لم تكن أبداً جزءاً من أي دولة أوكرانية مستقلة، ولكن تم منحها قسراً للجمهورية السوفيتية الاصطناعية من قبل فلاديمير لينين في عام 1922. إقرأ على موقع 180 بن مناحيم: “ضوء أخضر” روسي للتصعيد الإسرائيلي سورياً! “مضبطية إعادة التوجيه” مرة أخرى، سواء من خلال ما يسمى بـ”ثورة الورود” في جورجيا، أو الهزيمة الأميركية في البلقان، التي نجحت فقط في إنشاء جمهورية إسلامية – كوسوفو – في قلب أوروبا، يجب النظر إلى “الثورة البرتقالية” في كييف في سياقها كجزء لا يتجزأ من جهود المحافظين الجُدد والعولمة الشاملة لتعزيز أهدافهم الدولية. وهذه الأهداف ليس لها أي علاقة بالمعتقدات والقيم الغربية والمسيحية التقليدية. بل إنها كانت وما زالت تشكل تجسيداً لما عرَّفه عالم العولمة كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بأنه “مضبطية إعادة التوجيه الكبرى“، و”فرصة للتفكير في عالمنا، وإعادة تخيله، وإعادة ضبطه”. في الواقع، يأتي التوغل الروسي في أوكرانيا اليوم كنتيجة مباشرة ومتراكمة للأعمال التي دبرتها وزارة خارجيتنا (الأميركية) ومجتمع استخباراتنا، مع أتباعهم في أوروبا الغربية، على مدى ثلاثين عاماً، من أجل “وضع روسيا في مكانها- في الجزء الخلفي من الحافلة”. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد ألمح مؤخراً إلى أن أوكرانيا قد تعود إلى الوراء وتعيد النظر في قرارها بنزع السلاح النووي. وهذا، إذن، جنباً إلى جنب مع الاضطهاد العنيف للأقلية الضخمة الناطقة بالروسية داخل الحدود الأوكرانية، ما عجَّل بقرار بوتين اتخاذ إجراء عسكري صد كييف. فبعد عقود من الوعود الكاذبة، والمعاهدات المنقوصة، والبروتوكولات المُنْتَهَكَة، والتي لم تنفذها أوكرانيا أبداً، بتشجيع من دُعاة العولمة؛ لا سيما التنكر لاتفاقيتي “بودابست” و”مينسك” (والتي كان من الممكن أن تحسم القضايا بشكل منصف)، وجد “الدب الروسي” نفسه في وضع صعب، مع خيارات محدودة: إما أن يقف في وجه من يحاول أن إستبعاده وإخضاعه، أو المواجهة والتصدي للمؤامرة. لنتذكر مرة أخرى ما قاله الروائي العظيم المناهض للشيوعية، والمسيحي المتحمس والمناهض للشمولية، ألكسندر سولجينتسين: “كانت الأحداث في أوكرانيا، منذ الاستفتاء في عام 1991، مع خياراتها السيئة الصياغة، مصدراً دائماً للألم والغضب بالنسبة لي. لقد كتبت وتحدثت عن هذا كثيراً. إن إجراءات القمع المتعصب للغة الروسية (المفضلة لـ 60٪ من الناس هناك، بحسب استطلاعات) هي منهجية وحشية تستهدف في المقام الأول الآفاق الثقافية لأوكرانيا نفسها. الأراضي الشاسعة التي لم تكن يوماً جزءاً من أوكرانيا التاريخية، مثل شبه جزيرة القرم ونوفوروسيا والجنوب الشرقي بأكمله، تم استنزافها قسراً وتعسفاً في أراضي أوكرانيا الحديثة، وجعلها رهينة لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو. إنها كلها مزحة بسيطة لا يقبلها العقل، بل هي في الواقع مزحة سخيفة وقاسية استمرت بحق تاريخ روسيا في القرنين التاسع عشر والعشرين. في ظل هذه الظروف، فإن روسيا لن تخون، بأي شكل من الأشكال، ملايين المواطنين الناطقيين بالروسية في أوكرانيا، ولن تتخلى عن الوحدة معهم”(*). لا أحد – لا أحد أبداً – يريد الحرب، مع ما ينتج عنها من فوضى ودمار رهيب وخسائر في الأرواح. ولكن، وكما كتبت في مقالات سابقة (أنظر الكادر المرفق أدناه)، إذا كنت تبحث عن السبب الأساسي لما حدث، فالجواب ليس عند الروس الغزاة، وليس عند النظام في كييف، بل عند النظام الراعي (apparatchiks) في قاع ضبابي، في بروكسل، كما في مجلسي الكونغرس، ووسائل الإعلام الأميركية الــ”presstitute” (بحسب بول كريغ روبرتس)، التي أهملت الواجب الأساسي لنقل الأخبار بشكل محايد، وأصبحت مثل الرغوة في فم الكتائب المدافعة عن الثورة العدوانية في العالم الإداري (**). ففي الواقع، ليندسي غراهام وروجر ويكرز هما اللذان يحثان على استخدامنا المحتمل للأسلحة النووية ضد روسيا. سوف تُراق الدماء على أيدينا، أي على أيدي نُخَبنا. فكما قال رسام الكاريكاتير والت كيلي ذات مرة: “لقد إلتقينا بالعدو؛ والعدو هو نحن”. – المقالة بالإنكليزية على موقع “The Unz Review“ (*) ألكسندر سولجينتسين في مقابلة مع “دبليو. تي. تريتياكوف”، نشرتها “أخبار موسكو” في 28 نيسان/ أبريل و4 أيار/مايو 2006. (**) presstitute، مصطلح يشير إلى الصحافيين و”المتنفذين” في وسائل الإعلام الرئيسية، الذين يقدمون وجهات نظر متحيزة ومضللة، تخدم أجندة حزبية أو مالية أو تجارية معينة. *** أيدينا ملطخة بدم الأبرياء (*) “الاستنتاج البسيط للغاية الذي يمكن استخلاصه مما يحدث اليوم هو التالي: نخب السياسة الخارجية الأميركية؛ أي المحافظون الجُدد وأتباعهم المتحمسون في كل من الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي؛ يرون في روسيا عقبة رئيسية في استمرار عملية فرض والسيطرة الاقتصادية والسياسية على الدول التي لم تنضم إلى هيمنتها حتى الآن (أي روسيا والمجر). وباستخدام “الناتو” كصدفة إستراتيجية وأوكرانيا كلاعب في خط المواجهة، يسعى هؤلاء إلى الأهداف التالية: أولاً؛ منع حدوث كارثة اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة يسببها خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، الذي سيحقق لألمانيا ودول أوروبية أخرى، صعودا بعيداً عن الهيمنة الاقتصادية الأميركية. ثانياً؛ فرض حكومة مطواعة في موسكو، التي أصبحت حجر عثرة يحول دون هيمنة العولمة الجديدة وسياسة المحافظين الجُدد. – الحرب في فيتنام كانت في الواقع تعبيراً عن معارضة الشيوعية. أما الحرب ضد روسيا اليوم فلأنها تقف في طريق إعادة الهيمنة والعولمة الكبرى. – فلاديمير بوتين ليس بطلاً (…). لكن القلق الحقيقي اليوم؛ ويجب أن يكون مصدر قلق لجميع الأميركيين الوطنيين؛ هو في ما تمثله روسيا في سياق الجغرافيا السياسية العالمية، وتتعارض مع خطط وأدوات مؤيدي إعادة الهيمنة العالمية الكبرى والمحافظين الجُدد. هذا هو جوهر الموضوع وما يحدث في تلك المنطقة من أوروبا. – فكروا في ما حدث في العراق وقصة “أسلحة الدمار الشامل العراقية” الزائفة، والأكاذيب التي افتعلتها الولايات المتحدة للتدخل في البلقان. هل يمكننا الوثوق في مؤسسة السياسة الخارجية التي جادلت بما لا يقبل الجدل بأن “روسيا قد خربت” الإنتخابات الأميركية عام 2016، وأن ترامب كان “عميلاً روسياً”، وأن الروس كانوا يدفعون مكافآت لحركة طالبان لقتل الأولاد الأميركيين في أفغانستان وأن الروس قد خربوا شبكة الكهرباء في فيرمونت! – إذا كان عملاؤنا في كييف، الذين يتم حثهم بما فيه الكفاية من جانبنا، يمكنهم إثارة ما يكفي من العنف، وإطلاق ما يكفي من الصواريخ، وزرع ما يكفي من القنابل، فربما يتعين على الروس بالفعل التدخل.. وهذا بالضبط ما ترغب به بشدة نُخب وزارة الخارجية الأميركية. – إذا اندلع صراع خطير، فسوف تتلطخ أيدينا بالدماء، أي أن الحرب ستقع على أيدي مؤسستنا للسياسة الخارجية في واشنطن وأتباعها في أوروبا الغربية. – كم عدد الكوارث، والأكاذيب والتضليل، والقتلى الأميركيين، ومليارات الدولارات من دافعي الضرائب يجب إنفاقها على مذبح نخب العولمة القوية، وتُجار الأسلحة الجُدد/ كبار رجال الأعمال واليسار المسعور الذي يحتقر القومية المتنامية في روسيا والمجر لأنها تقف في طريق سيطرته على العالم”؟
——————————–
=================
تحديث 06 أذار 2022
————————
“لا تتراجع حتى تصبح لك الغلبة”: فلاديمير بوتين، “بطل خارق” مفتول العضلات أم شخصية “سيكوباتية”؟/ محمد خلف
ليس سهلا فهم شخصية مثل فلاديمير بوتين. الزعيم الروسي الذين نشأ فقيرا وتدرج في الاستخبارات يخوض حروباً قاسية وحشية يمارس لعبة القوة الجسدية والعسكرية مستنداً الى تاريخ من السلطة المطلقة والثراء الفاحش والرغبة في سحق الخصوم.
في عام 2015، نشر نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين على تويتر صورتين لكلٍّ من فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما جنبا إلى جنب، يظهر فيها بوتين وهو يحمل بيديه نمراً، وفي الجانب الآخر يظهر أوباما وهو يحمل كلبا صغيرا ورقيقا، وكتب على الصورة: “لدينا قيم مختلفة، وحلفاء مختلفون”.
اثارت هذه الصورة والتعليق عليها انتباه فريق من الباحثين من جامعة سانت جون الأميركية ودفعتهم بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا الى دراسة شخصية الرئيس الروسي، وقاموا بتطويرها لاحقا بعدما تدخَّلت موسكو عسكريا في الحرب السورية. تفاصيل هذه الدراسة نُشرت بعد ضجة التدخُّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
اتبعت الدراسة منهج عالِم النفس الأميركي تيودور ميلون في تحليل الشخصيات السياسية، وتُعرَّف الشخصية هنا بأنها: “نمط معقد من الخصائص النفسية المتجذرة بعمق التي تكون إلى حدٍّ كبير غير واعية ولا يمكن تغييرها بسهولة، وتُعبِّر عن نفسها تلقائيا في كل جانب من جوانب الأداء تقريبا”.
يحدد ميلون عشرة عوامل يحصل فيها الشخص، بحكم سلوكه الظاهر للباحثين، على تقدير يتراوح من الضعيف إلى المَرَضي، وفي الحالة المَرَضية تظهر اضطرابات الشخصية مثل النرجسية والحدّية وغيرها. لم يحصل بوتين على أية درجة مَرَضية في تلك المعايير، لكنه سجَّل درجة عالية جدا في ثلاثة منها وهي: “السيطرة، والطموح، ويقظة الضمير”، وهي تشير برأيه إلى “الحذر والاجتهاد والإتقان”.
إذا دقّقنا في هذا النوع من الشخصية السيكوباتية بالسمات النرجسية نجد أن مثل هذه الشخصيات تميل إلى البقاء خارج الحدود القانونية كما وأنها لا تبالي برفاهية الآخرين. ومن ثم لا تشعر بالندم عندما يتلاعب المحيطون بهم من الناس مهما كانت مواقعهم الاجتماعية ،بحيث تقرر امكانية التلاعب بهم واستغلالهم.
وفي حوار مع صحيفة غربية قال بوتين “يجب أن تُغلِّف أفعالك بالمصداقية، ولا تتراجع حتى تصبح لك الغلبة، وبعد أن يستسلم خصمك وتؤسس مجالك وشروطك، يمكنك حينئذٍ تصحيح الأمور والمضي قدمًا استعدادًا للمواجهة التالية”.
فائض القوة واللكمة الأولى
الممارسة اليومية للزعيم الروسي اتسمت منذ طفولته بمشاعر من يمتلك فائض القوة والقدرة على التوجيه والإقناع. لايتحرّج في أن يُملي قوانينه على الآخرين ويكون مستعدا للضغط عليهم من أجل الامتثال للأوامر. تحدث بوتين شخصيا على موقع إلكتروني مخصص لسيرته قائلاً: “إنني آت من عائلة متواضعة، وعشت هذه الحياة لفترة طويلة جدا “.
لم تكن خلفيات بوتين الاجتماعية تمهد لوصوله إلى أمجاد الكرملين، إذ ولد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1952 في عائلة عاملة تعيش في غرفة واحدة من أحد المساكن المشتركة في لينينغراد.
نشأ بوتين في مجمع في منطقة سكنية شعبية وكان يتشاجر كثيرا مع الصبية المحليين الأضخم حجما والأشد منه قوة. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، اقر بوتين: “قبل خمسين عاماً، علمتني شوارع لينينغراد قاعدة مفادها أنه إذا لم يكن لابد من خوض معركة ـ فعليك أن تسدد الضربة الأولى”. ولذا نجده يستخدم وهو رئيس البلاد لغة مقاتلي الشوارع الفظة للدفاع عن هجومه العسكري على الانفصاليين الشيشان، إذ توعد بسحقهم ومطاردتهم في كل مكان “حتى في المراحيض”.
في كتابه المعنون ( القيصر الجديد: بزوغ عهد فلاديمير بوتين)- ‘The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin- للباحث الأميركي سيفن لي مايرز “بوتين في احد ايام مايو- آيار العام 1959 او ربما 1960 في أيام صباه الأولى خرج مع أقرانه في مغامرة دون علم والده أو والدته، واستقلوا قطارا الى منطقة بعيدة في المدينة لم يذهبوا اليها من قبل بحثا عن مغامرة، كان الجو قارساً، وعندما عاد متأخرا الى البيت وجد والده في انتظاره غاضبا فانهال عليه بالضرب بحزامه الجلدي وأمره بعدم مغادرة الحي الذي يسكنونه دون اذن منه، وإلا سيكون عقابه القادم اكثر صرامة”.
ووفقا للكاتب فإن بوتين كان” تلميذا غير مبال ومشاكسا، فظاً وسريع الغضب، ووصفه زملاؤه التلاميذ في الصف بـ”الدوامة” لانه لا يتوقف عن الدوران في حلقة مفرغة داخل غرفة الصف، فضلا عن أنه عنصر تخريب في المدرسة، وذات يوم وبعد عراك مع أحد التلاميذ عثر في حوزته على سكين”.
هذا السلوك العدواني كما يروي مايرز ظل أحد سمات شخصيته حتى خلال دراسته في المرحلة الثانوية، ما استدعى توبيخه من قبل لجنة الأشبال الحزبية وتهديده بإرساله إلى الإصلاحية إذا ما كرر هذه التصرفات العدوانية”. وينقل المؤلف عن معلمته في المدرسة التي درّسته حتى الصف الرابع فيرا جورجوفيتش انها “اضطرت الى أن تشتكيه إلى والده، وقالت له: ابنك ذكي ولكنه مهمل وغير منظم ومشاكس”. واضافت “أدليت برأيي هذا إلى فلاديمير الأب في بيته”، الذي وصفته بأنه “بدا بارداً للغاية وفظيعاً”. عندها رد والده “ماذا يمكنني أن أفعل؟ اقتله ام ماذا؟”.
المستشارة وكلب بوتين
تتمحور إستراتيجية الهيمنة الخاصة ببوتين، حول كون معظم الناس يتعرَّضون للترهيب في مواجهة العداء والسخرية والنقد والتهديدات، ولهذا يبرع في إرهاب وإذلال وإكراه الآخرين على الاحترام والخضوع. هنا تفاصيل حالتين فقط وجدتا صداهما في الميديا الروسية والعالمية.
واحدة من أبرز الحكايات حين انتهز بوتين فرصة زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الكرملين، ليحضر لها كلبه والمصوّر كي يلتقط بعض الصور التي تظهر سيدة برلين في حالة من القلق والخوف، فيما يظهر هو أمام العالم ثابتاً وغير مكترث. وفقاً لصحيفة “دي فيلت الألمانية”، الواقعة على ما يبدو كانت مدبرة، لأن بوتين كان يعلم أن لدى ميركل مخاوف من الكلاب بسبب تعرّضها للعض في طفولتها.
في عام 2007، التقى رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي مع بوتين على هامش قمة “مجموعة الثمانية” (التي صارت “مجموعة السبعة” بعد طرد روسيا عقابا على احتلال وضم القرم الأوكرانية في 2014)، وبثت قناة “فرانس 2″ تقريراً مصوراً عن اللقاء، أشارت فيه إلى أن ساركوزي وجه اللوم إلى بوتين حول قتله أعدادا من الشيشان، واغتياله الصحفية الروسية آنا بوليتكوفسكايا، وعنفه مع المثليين في روسيا. وسأل بوتين ساركوزي إن كان انتهى من حديثه ليرد عليه قائلا” إن “حجم فرنسا صغير جدا” مشيرا إلى ذلك بإصبعين، وأن “حجم روسيا ضخم”، فاتحا ذراعيه أقصى ما أمكنه. ثم أضاف بوتين بلهجة حادة قاربت الصراخ: “اذا تواصل حديثك معي بهذا الشكل سأسحقك، أو تصمت الآن”.
يتمركز سلوك بوتين مع الآخرين، بحسب تحليل جامعة سانت جون، حول وجوده القيادي؛ فهو قوي وموثوق وتوجيهي ومقنع، وغالبا ما يسعى الى أن يُملي قوانينه على الآخرين ويكون مستعدا للضغط عليهم من أجل الامتثال لأوامره وقراراته مهما كان الثمن.
سياسياً، كثيرا ما يجد الأفراد أصحاب هذا النمط الإكراهي، بكل تدرُّجاته، مكانا ناجحا لأنفسهم في الأدوار التي تحظى فيها السلوكيات العدائية بالإعجاب الاجتماعي، مما يوفر منفذاً للعداء الانتقامي المتخفي تحت ستار المسؤولية الاجتماعية. كما جميع أشكال هذا النمط، تمتاز هذه الشخصية بقدر من الجرأة والوقاحة التي غالبا ما تعكس الثقة والسلطة وتُثير الإعجاب والامتثال من الآخرين.
لغة الجسد والعقل الباطني
الألمانية المتخصصة في تحليل لغة الجسد مونيكا ماتشينغ اعتبرت أن خطوات بوتين أثناء سيره تثبت أن هناك قدراً كبيراً من التمثيل فيها، وتضيف أنه يتعمّد أن ينفخ نفسه كي يوحي بالقوة، ولديه رعشة خفيفة في الكتف الأيسر تثبت أنه يريد أن يتحرك بشكل أكبر لكنه مجبر على الثبات كي توحي صورته بما يريد أن يراه ويتقبله الآخرون”. وتضيف: “ليس خافيا أن بوتين سعى ونجح على مدار سنوات، في هندسة صورته الشخصية أمام العالم، قادةً وشعوبًا. ومع ذلك، فلا يعلم أحد الكثير عن حياته الشخصية، فالعالم يعرف عنه ما يريده أن يُعرِّف به نفسه”.
استخدم بوتين لغة الجسد والاستعراضاته الجسمانية الخارقة بنشر صوره عاري الصدر، ثم لحقتها صوره وهو يصطاد النمور، أو يركب الخيل لكي يجذب الانتباه وينال الاعجاب ونجحت تلك السياسة في سلب عقول عامة الروس، ورأوا في قوة بوتين الجسدية دليلًا على قدرته على حماية روسيا ككل. كما حقق استثماره الجسدي أهدافه بعدما اعلن 48% من الروس في استطلاع للرأي أنهم يرغبون أن يبقى بوتين رئيسًا إلى الأبد. وازدادت هذه النسبة مع حفاظ بوتين على حياته الخاصة بعيدًا من الأضواء، فلا تُنشر له فضائح ولا يؤلف أحد من أفراد أسرته كتبًا عنه. والأهم أن أسرته الصغيرة تظهر بمظهر ناجح، فابنته الصغرى، كاترينا، تشغل منصبًا رفيعًا في جامعة موسكو، وترقص الأكروبات. أما ابنته الكبرى، ماريا، فتعمل طبيبة متخصصة بالغدد الصمّاء.
ويخبرنا التاريخ الماضي والقريب ويروي لنا لو بحثنا في أحداثه عن نماذج وشخصيات “سيكوباتية” لديها ميول معادية للمجتمع، تعود في غالبيتها إلى عوامل اجتماعية أو بيئية، وقد تكون الصفات الذهنية التي يتسم بها الشخص السيكوباتي فطرية أكثر من كونها مكتسبة. بوتين كما صدام حسين ومعمر القذافي شخصيات عصابية تحمل جميعها عدداً من الصفات السلوكية والاستجابات العاطفية غير الطبيعية؛ تنقصها مشاعر التعاطف والشعور بالذنب أو الندم، كما أنها تتحلى دوماً بالتلاعب والخداع.
أشهر حوادث التاريخ وأكثرها ذيوعا هي قصة “اجاثوكليس” (289-361)، حاكم سرقوسة، وأحد زعماء الإغريق والحرب الأهلية (الديموقراطيين)، الذي توج نفسه ديكتاتوراً، بطريقة فريدة، وقد سجل “ميكافيلي” هذه الحادثة في كتابه “الأمير” وأشاد ببراعة الوسيلة التي نصب فيها اجاثوكليس نفسه ديكتاتورا، فقد استدعى الشعب وممثلي المجالس الشعبية، كما لو أنه سيتداول معهم في شأن عظيم من شؤون الدولة، وبإشارة من يده قام حرسه الشخصي بذبح الزعماء المنافسين، وبذلك توج نفسه حاكما وحيداً، وبرر اجاثوكليس هذا الإجراء بالضرورة التي تمليها عليه مصالح شعبه، في حربه الفاشلة التي شنها ضد الأعداء الخارجيين!
أليس هذا ما فعله صدام حسين والقذافي وما يفعله بوتين في أوكرانيا وسوريا وليبيا؟
صدام حسين كان محروما في طفولته من العناية الابوية ومن الامومة، ويعاني من الفقر والحرمان، هذا ما يعتقد باحثون أنه ما دفعه إلى إذلال العراقيين ووضع البلاد ومواردها في قبضته لخدمة أوهامه بالعظمة والتفوق، فأراد أن يجعل من نفسه امبراطورا، ما جعله ينفق المليارات ليس على الحروب العبثية فحسب، بل أيضا على بناء القصور الفخمة، ساعيا الى تعويض مرارة الحياة والحرمان والإذلال الذي عاشه منذ صغره.
بوتين هو الآخر بنى إمبراطورية من الممتلكات الباذخة وراكم ثروة جعلته يُعتبَر ثالث أغنى سياسي في العالم، سواء بقصره الذي فضحه المعارض نافالني وصور عنه فيلما عرضه على يوبتوب وتقدَّر قيمته بمليار دولار، أو الطائرة المطلية بالذهب، والساعات التي تقدّرقيمتها بسبعمئة ألف دولار، وجميع هذه الممتلكات تلخص طراز حياة الأباطرة التي يعيشها وجعلته ينفصل عن الواقع.
ووفقاً لتقريرٍ يحمل عنوان “حياة قادس” فإن بوتين الذي نجح في جلب الاستقرار السياسي والاقتصادي لنظام الحكم في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الكيان المؤسساتي للدولة، يمتلك أربعة يخوت و43 طائرة، تتضمّن إحداها مرحاضاً بقيمة 75.000 دولار، و20 منزلاً فاخراً، و15 مروحية، والقائمة تطول.
إحدى الطائرات التي تستحق الذكر هي Ilyushin Il-96، التي تتميّز بحجرة تقدَّر قيمتها بثمانية عشر مليون دولار، مرصّعة بالجواهر والجلد المستورد من الشركة الإيطالية التي تصدِّر الجلود لشركة أوستن مارتن. هذا عدا عن المنزل الذي يقيم فيه والذي تبلغ مساحته 2.300 فدانا، والمتضمّن صالة سينما، ومضمار بولينغ، وكنيسة رئاسية. وتبلغ كلفة طراز حياة بوتين 2.4 مليار دولار سنوياً. قدّر ستانيسلاف بيلكوفسكي، المحلل السياسي الروسي والناقد لبوتين، أن الرئيس الروسي كان لديه صافي ثروة قدره 70 مليار دولار في عام 2012، في تقرير لمكتب الصحافة الاستقصائية (Bureau) ، وأن الرئيس الروسي لديه حصص في شركات النفط والغاز الروسية مثل “غازبروم” و”سورجوت نايف تيجاس”.
فيما يقدم أندرس أصلوند، الاقتصادي السويدي ومؤلف كتاب “رأسمالية روسيا: الطريق من اقتصاد السوق إلى نظام كليبتوقراطية”، تقديرا أعلى لثروة بوتين، مشيرا الى أن لدى بوتين ما بين 100 مليار دولار و150 مليار دولار في الأصول. بنى أصلوند حساباته على ثروة المقربين من بوتين، وووفقاً لدراسته وبحثه فإن أصدقاء بوتين يمتلكون ما بين 500 مليون دولار وملياري دولار لكل منهم نيابة عن الرئيس الروسي.
ثروة القيصر وذكوريته المفرطة
نشرت مجلة التايمز الأميركية تقريرا مطولا تحدثت فيه عن ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السرية، مشيرة إلى الشركات التي يمتلك حصصا فيها، وبعض الأملاك والأصول المخفية: “يقولون إن المال يساوي القوة، ويبدو أن بوتين يمتلك الكثير من القوة، لكن كم لديه؟ هو لا يبوح بذلك أبدا”.
أضافت الصحيفة: “تعد معرفة القيمة الصافية لثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا أسمى لكثير من العملاء السريين والقراصنة حول العالم، لكن ثروة “عميل الاستخبارات الروسي السابق”، وفك شيفرة توزيعها تكاد تكون معقدة، فهي على الأرجح موزعة بين شبكات سرية من الشركات القابضة، والعقارات فضلا عن حسابات بنوك لأشخاص آخرين.
يحرص بوتين وجهازه الترويجي لإظهار ذكوريته و تفوقه وقدراته الخارقة في صعود الجبال وسباحة المسافات الطويلة ورياضة الجودو، وكان ذكر شخصيا أنه في صغره تعلّق برياضة السامبو وعشق شخصية الجاسوس التي شاهدها في أحد الأفلام عندما كان تلميذا في المرحلة الثانوية .
أصدر الكاتب الفرنسي برنار شامباز رواية جريئة، تناولت شخصية بوتين مباشرة ومن دون محاباة أو التفاف، بصفته رجل المرحلة والقائد الجديد للأمة الروسية، وعنوانها “فلاديمير فلاديميروفيتش”. وصف هذا الروائي بوتين بـ”الرئيس بعينيه اللتين تشبهان عيني “الفقمة” والذي يخفي في تقاسيم وجهه حالاً من الوجوم أو الحزن القديم هو بطل هذه الرواية التي يتولى السرد فيها قرين له يحمل الاسم نفسه “فلاديمير فلاديميروفيتش”.
ويروي كيف أن مواطنا عاديا كان يعمل مدرساً للأدب، ساقه حظه العاثر إلى أن يحمل اسم “الزعيم” نفسه الذي تقارنه بعض الصحف الأوروبية بهتلر أو صدام حسين، والذي كان تلقى عام 2014 صفعة “مجازية” من الرئيس الأميركي أوباما عندما أدرج روسيا البوتينية في محور الشر العالمي مع الأصوليين الإسلاميين ومرض إيبولا “.
هذا فيما تواصل الروائية البيلاروسية، الأوكرانية المولد والنشأة، سفيتلانا أليكسيفيتش، التي حازت جائزة نوبل في العام “2015 ” منذ سنوات السخرية في كتاباتها من الرئيس الروسي و لا تكف عن انتقاده واصفة اياه بسخرية بـ”الشخص الذي يجسد المجد الروسي الغائب”. وانتقدت بسخرية جارحة ظهوره “الكاريكاتوري “وهو عاري الصدر، أو حاملاً بيده بندقية”. وقالت “هذا الرئيس الذي “ينسى دوماً وعوده بالإصلاح أو يتناساها ويصر على محاربة المثليين”، وانتقدت بقسوة حملته الشعواء على فرقة “بوسي رايوت” الموسيقية، وكذلك زجه مغنيتين في السجن عقاباً على نقدهما سياسته القيصرية.
تحول بوتين الى اضحوكة في أوساط الكتاب والمثقفين الروس بعدما وضع قبضته على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وجعل من راعيها البطريرك كيرل ألعوبة في يديه، لاسيما بعد قيام الأخير بمباركة بوتين في سبتمبر (أيلول) 2015 عشية خوضه ما سمي حينذاك “الحرب المقدسة” في سوريا والمنطقة، ضد “داعش” والجماعات الظلامية، دفاعاً عن مسيحيي الشرق”.
درج
——————————-
لاجئون شقر بعيون ملونة/ حسام القطلبي
تطرح الخطوات الفعالة والاستجابة السريعة الإيجابية للأزمة الأوكرانية أسئلة داخل أوساط المعنيين في الاتحاد والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول التمييز في التعاطي مع اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بلاجئي دول أخرى.
فتحت أوروبا كلها حدودها مؤخراً أمام الهاربين من أوكرانيا من ويلات الغزو الروسي. سريعاً، وافق مجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية الحماية المؤقتة للأوكرانيين، ما يعني أن كل أوكراني يستطيع الإقامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات في دول الاتحاد الأوروبي دون أي حاجة للمرور عبر إجراءات طلب اللجوء الطويلة وتعقيداتها ويسمح له بالوصول واستخدام كل خدمات الضمان الصحي والتعليم والسكن والرعاية الاجتماعية وخلافه في دول الاتحاد. ويعني أيضاً أن دول الاتحاد ستكون متكافلة ومتضامنة في استقبال اللاجئين الأوكرانيين دون أي تفاوت بينها في السياسات المحلية ذات الصلة.
كانت هذه الآلية قد أنشأت في الاتحاد في العام 2001 كاستجابة لأزمات إنسانية في كل من يوغسلافيا السابقة وكوسوفو ولم يتم تفعيلها في أي وقت سابق قبل الآن.
تطرح الخطوات الفعالة والاستجابة السريعة الإيجابية للأزمة الأوكرانية أسئلة داخل أوساط المعنيين في الاتحاد والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول التمييز في التعاطي مع اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بلاجئي دول أخرى.
هناك لاجئون هربوا من أزمات وحروب طاحنة في بلدانهم واضطروا أن يعبروا البحار والغابات ليموت آلاف منهم غرقاً أمام شواطئ اليونان وإيطاليا أو في الغابات الموحشة الممتدة بين كرواتيا و هنغاريا وصربيا، أو مؤخراً جداً في تلك الغابات الباردة على الحدود البيلاروسية البولونية، لكن مُنِعَ عنهم أي وصول للمنظمات الإنسانية المعنية أو وسائل الإعلام ليموت كثيرون منهم ويدفنوا هناك بصمت.
أضف إلى أن أياً من دول الاتحاد غير متورطة على الأقل بشكل مباشر في بداية النزاع العسكري الحالي في أوكرانيا، في مقابل حقيقة أن أغلب اللاجئين من غير الأوكرانيين جاؤوا من بلدان تورطت فيها قوات من بلدان من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في النزاع كأفغانستان أو العراق أو سوريا أو من مستعمرات سابقة لدول من الاتحاد ترفض حتى اليوم الاعتراف بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ارتكبتها فيها كالجزائر أو تشاد أو مالي.
تقارير دولية وإعلامية عدّة سجلت تمييزاً فاضحاً على الحدود البولندية الهنغارية في التعامل مع القادمين من أوكرانيا بين المواطنين الأوكرانيين والمقيمين هناك من غير المواطنين، من هؤلاء طلاب وعمال ومقيمين ولاجئين في أوكرانيا من الأفارقة أو بلدان الشرق الأوسط. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مؤخراً مقاطع عدة لمراسلين ومحللين على شاشات عالمية يتحدثون بوجوه مندهشة مستنكرة عن لاجئين شقر ذوو عيون ملونة٬ متحضرين أوروبيين بخلاف ما اعتادت أوروبا أن تستقبله من لاجئين قادمين من بلدان أقل شأناً.
في الصورة الأوسع فإن ردّ الفعل الغربي والأوروبي خصوصاً على الغزو الروسي لأوكرانيا والجرائم التي ترتكبها القوات الروسية هناك، يختلف في طبيعته وحدته في التعامل الأوروبي مع حالات مماثلة في دول أخرى ارتكبت فيها هذه القوات نفسها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما حدث في سوريا مثلاً. ويتعدى نقاش التمييز العنصري هنا إلى نقاش آلية التعامل مثلاً مع ملاك روس لأندية أوروبية كما في حالة نادي تشيلسي الانكليزي المملوك للملياردير الروسي رومان ابراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعرض هذا المالك لضغوط العقوبات التي اضطرته لوضع ناديه برسم البيع مؤخراً في محاولة للهروب والالتفاف على خطوات العقوبات الدولية المتسارعة ضد روسيا والأوليغارشية الروسية.
في المقابل فإن رابطة الدوري الانكليزي نفسها ترحب بملكية نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي وملكية نادي مانشستر سيتي الانكليزي لإمارة أبو ظبي مع تورط كلاً من السعودية والإمارات في حرب طويلة دامية وجرائم حرب دامغة في اليمن. بل أن مفاوضات قائمة على قدم وساق اليوم لضم كل من ناديي آدو دنهاخ الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي إلى ملكية صندوق الاستثمار السعودي في الوقت الذي تقوم فيه الأندية الأوروبية والاتحادات الرياضية الأوروبية بفسخ عقود رعايتها من قبل شركات الطاقة الروسية كغازبروم كجزء من الاحتجاج والعقوبات الأوروبية على غزو روسيا لأوكرانيا.
على المستوى السياسي يظهر التمييز واضحاً بين حالة اللاجئين الأوكرانيين وغيرهم ليس فقط في بولندا التي عارضت في كل وقت استقبال أي من اللاجئين أو السماح لهم بعبور حدودها إلى دول أوروبية أخرى ترحب باستضافتهم كألمانيا أو هولندا، وهي اليوم تستنفر كل طاقة منظماتها ومؤسساتها الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وترحب بهم كما يستحق كل لاجئ هارب من ويلات الحرب وفقاً لتعهدات بولندا الدولية داخل الاتحاد الأوروبي ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة. أيضاً تجد دولاً كهنغاريا لا تزال على المستوى السياسي تعارض بوضوح قبول أي لاجئ على أراضيها وترفض التعامل مع قرارات بروكسل الخاصة بتوزيع اللاجئين على مختلف دول الاتحاد بل أن سلطاتها الأمنية متهمة باحتجاز مئات اللاجئين الذين كانوا يعبرون أراضيها في ظروف بالغة السوء وتعريضهم للإذلال والتعذيب في بعض الحالات.
يفتح اليوم الرئيس الهنغاري اليميني المحافظ فيكتور أوربان المجال مع اقتراب الانتخابات العامة في بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الذين يحصلون على تعاطف شعبي متزايد هناك. ثم لا تكاد تسمع أي اعتراض سياسي من أي من أحزاب اليمين في البلدان الأوربية حتى تلك التي كانت حتى الأمس القريب تحج إلى موسكو وتغازل بوتين والتي اعتدنا دائماً على برامجها السياسية التي تضع في رأس أولوياتها إغلاق الحدود في وجه اللاجئين ورفض سياسات الهجرة الأوروبية والانتقاد الحاد في كل حين لأي سياسات حكومية في بلدانهم قد يصنفونها كتسهيلات لاستقبال اللاجئين بحجة الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصيات الثقافية.
بالتزامن مع الخطوات الإيجابية والهامة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فإن أفضل ما قد يحصل الآن هو فتح هذا النقاش واسعاً داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي كما على المستويات المحلية في كل بلد أوروبي. لكن حتى على وضوح هذا التمييز وسطوعه فإن أحداً حتى الآن لا يبدو أنه يريد أن يلقي بالاً لذلك مع قرع طبول الحرب في كل مكان في القارة. هو نقاش مؤجل يضاف إلى قائمة طويلة من قضايا عديدة خاصة بالحقوق والمساواة والعدالة من المرجح أنها ستطول أكثر مع التوجه الأوروبي الجديد نحو رفع الإنفاق الدفاعي والعسكري والأمني والذي غالباً ما تكون قضايا إنسانية من هذا النوع أول ضحاياه. في هذا أيضاً انتصار للبوتينية لا يبدو جانبياً أبداً.
درج
—————————–
الدعاية الروسية: عنزة ولو طارت!/ ماجد كيالي
الادعاءات الروسية أتت غاية في الرثاثة والسذاجة والاستخفاف بالعقول، إلى حد إنها تريد تحويل الضحية إلى جلاد، والجلاد إلى ضحية، وإلى حد نسيان طبيعة النظام الروسي، وخياراته إزاء شعبه، وفي البلدان المحيطة به، وفي سوريا.
رئيس أوكرانيا اليهودي نازي، وبوتين يريد نشر الديمقراطية، والجيش الروسي بمثابة المخلص يريد فقط تحرير الأوكرانيين، ولو بالطائرات والدبابات، يعني “عنزة ولو طارت”.
هذا باختصار شعار الحرب الإعلامية الروسية، التي تواكب الحرب البوتينية، في أوكرانيا.
من يتابع إعلام روسيا، والناطقين باسمها، وحتى المتعاطفين معها، وضمنهم الذين يتخيّلون أنهم مازالوا في زمن الاتحاد السوفييتي، يظنّ أن أوكرانيا هي التي اجتاحت روسيا، وأن دباباتها وطائراتها وصواريخها تدك المدن الروسية، وأن مئات ألوف المشردين هم روس وليسوا أوكرانيين، وأن الجيش الروسي هو حمامة سلام، وحامل لواء الحرية والديمقراطية.
طبعا ثمة بعض متشاطرين، أو أكثر ذكاء، يريدون أن يضفوا نوعا من الموضوعية على ادعاءاتهم، في دفاعهم عن تلك الحرب، فيذهبون إلى عدم إنكار الوقائع، لكن مع تحميل الطرف الأوكراني مسؤولية الجرائم التي ترتكبها روسيا بحق الأوكرانيين، ما يذكر بإسرائيل وادعاءاتها الصلفة، وضمنه غولدا مائير التي قالت مرة: “لن أسامح الفلسطينيين لأنهم يجبرون جنودنا على قتلهم”!
كنا في بداية الأحداث مع كلام روسي عن مجرد مناورات عسكرية روتينية في الأراضي الروسية، ثم في الأراضي البيلاروسية، مع تأكيد أنه لا يوجد أية نوايا حربية، بيد إن الأمر انتقل في مرحلة تالية إلى الحديث عن اشتباكات في إقليم دونباس، بين أقلية روسية والجيش الأوكراني، ليتبع ذلك إعلان قيام جمهوريتين مستقلتين في هذين الإقليمين، اعترفت بهما روسيا بلمح البصر، ثم سرعان ما عقد رئيساهما معاهدة صداقة ودعم مع روسيا، في اجتماع لهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بث في الفضائيات. في المحصلة دخلت القوات الروسية الحرب، تحت ذلك الغطاء، دفاعا عن تلك الأقلية، وعن هاتين الجمهوريتين، ما يذكر بحجة “الدفاع عن الأقليات”، التي استخدمها النظام السوري وشريكه الروسي للبطش بالسوريين وتشريدهم.
منذ تلك اللحظة بتنا أمام روايات متناسلة لتبرير الحرب على أوكرانيا، منها منع اللغة الروسية، ثم نية أوكرانيا الانضمام إلى حلف ناتو، مع إن الحديث عن مجرد نية، مع العلم أن ألمانيا وفرنسا أكدتا للرئيس الروسي أن ذلك لن يحصل، وأنه غير مطروح، وأنهما لا توافقان على ذلك.
في البداية تم تصوير الأمر وكأن روسيا تريد أن تحتاط لضمان عدم دخول أوكرانيا لحلف ناتو، وأنها ستعمد لاستعادة أراضي إقليم دونباس كاملة، لمنح الجمهوريتين الناشئتين مجاليهما الحيوي الإقليمي، لكن الأمر تطور إلى حرب على أوكرانيا كلها، وبات القصف يطاول عديد من المدن ومنها العاصمة كييف.
مع لحظة انكشاف أن هدف بوتين تطويع أوكرانيا كلها، تطور الخطاب الإعلامي الروسي، فإذا بالأمر يتعلق بمحاربة الطغمة النازية في أوكرانيا، التي تسيطر على الحكم، وعلى الشعب الأوكراني، وهو ادعاء لم يهضمه أحد إطلاقا، علما إن الرئيس يهودي، وأن روسيا حاربت السوريين ودكت مدنهم وشردتهم دفاعا عن النظام السائد في سوريا منذ أكثر من نصف قرن، وهي في ذلك ادعت مقاتلة الإرهابيين.
ثم ظهر ادعاء آخر مفاده أن النظام الأوكراني يقوم بإبادة جماعية، من دون أن يعرف من الذي أبيد، مع السجل الوحشي للجيش الروسي، في عهد بوتين، في الشيشان وجورجيا وأوكرانيا ذاتها وفي سوريا أيضا!
في خطابه، الذي برر به الحرب، تحدث بوتين صراحة، في محاضرة عن التاريخ، وعن الجغرافيا والديمغرافيا، والعلاقات الدولية، مؤكدا أنه لا يوجد شيء اسمه أوكرانيا، ولا شعب أوكراني، وأن أوكرانيا هي روسيا، ما يذكر بشعار الحركة الصهيونية: “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”!
كان ذلك الخطاب واضحاً، ومباشراً، وهو يدحض، أو يفضح خواء، مجمل الادعاءات التي ظلت تروجها الدعاية الروسية لتبرير الحرب، والتي لا علاقة لها بالمنطق، وتنم عن الاستخفاف بالعقول، واللامبالاة بالأثمان الباهظة التي تلحق بالشعبين الروسي والأوكراني.
مع ذلك ظلت الخطوط الأساسية للدعاية على حالها، حتى لدى الرئيس ذاته، في أن الأمر يتعلق بمحاربة النازيين، الذين يقومون بأعمال إبادة جماعية، لكن أكثر دعاية، لم تكن مهضومة أبدا، تمثلت بتبرير الحرب بإزاحة النظام اللاديمقراطي في أوكرانيا، علما أن الحديث يدور عن رئيس أتى بأغلبية كبيرة، وبرلمان منتخب، وكأن بوتين أبو الديمقراطية، أو كأن النظام الروسي نموذجا يحتذى في التربية على الديمقراطية، أو كأن الديمقراطية يمكن أن تفرض بالدبابات، لكأنه لم يقلب سوريا عاليها واطيها للحفاظ على نظام الفساد والاستبداد في سوريا.
ادعاء آخر، أكثر سماجة، تمثل بتخوف روسيا من نوايا أوكرانيا تملك أسلحة نووية، علما إن أوكرانيا سلمت كل مخزونها من تلك الأسلحة (إبان العهد السوفييتي) إلى روسيا ذاتها في العام 1994، وأن روسيا تمتلك ترسانة نووية هي الأولى أو الثانية في العالم، قبل أو بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مع التذكير بأن بوتين لوح بوضعه ترسانته النووية أهبة الاستعداد، ما أثار مخاوف العالم.
في الحديث عن وقف الحرب والذهاب إلى حل سياسي اشترط بوتين أن توافق أوكرانيا على شروطه كاملة، أي أنه فقط يريد استسلام أوكرانيا، لإرضاء غروره، وإشباع روح الغطرسة لديه، والامتلاء بالشعور بالقوة.
الادعاءات الروسية أتت غاية في الرثاثة والسذاجة والاستخفاف بالعقول، (وهذا لا يعني أن الدعايات أو الادعاءات الأخرى أفضل، ولكن ذلك موضوع آخر)، إلى حد إنها تريد تحويل الضحية إلى جلاد، والجلاد إلى ضحية، وإلى حد نسيان طبيعة النظام الروسي، وخياراته إزاء شعبه، وفي البلدان المحيطة به، وفي سوريا.
والحقيقة فإن الخوف على روسيا لا يأتي من خارجها، وبالتأكيد ليس من أوكرانيا، ولا من أي تهديد عسكري خارجي، وإنما هو يأتي من داخلها، من طبيعة نظامها، وتفرد رئيسها بالسلطة، فهو يعتبر نفسه أبو روسيا، وهو كفرد المتحكم بمواردها وبجيشها وبخياراتها.
في التجربة التاريخية ثبت أن الاتحاد السوفييتي انهار من داخله، بسبب العورات التي اكتنفته، إذ هو لم يسقط بحراكات شعبية من داخله، ولا بحصار، أو بحرب، من الخارج.
تدخلت روسيا بوتين في سوريا لوأد طلب الشعب السوري للحرية بدعوى الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها، لكنها في أوكرانيا نقضت تلك الحجة بخفة ولا مبالاة، بسعيها مصادرة سيادة أوكرانيا، وتجزئة أراضيها، وهي لم تقم جمهورية واحدة في إقليم دونباس، أي في أراضي أوكرانيا، بل جمهوريتين، وربما تقيم جمهوريات أخرى، فالعصر البوتيني مفتوح على الاحتمالات والمخاطر والادعاءات الغريبة والسمجة.
درج
—————————————-
عن “الأسوأ الآتي”/ حسام كنفاني
تُجمع التعليقات الغربية حالياً على الاجتياح الروسي لأوكرانيا على الخشية من أن “الأسوأ لمّا يأتِ بعد”، حتى إنّ الاستخبارات الأميركية في التقارير الداخلية التي تسرّبت إلى الإعلام باتت تحذّر من خطر “حشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الزاوية”، وما قد يجلبه ذلك من ردّات فعل لا تُحمد عقباها.
مخاوف كهذه لها ما يبررها بالاستناد إلى وضع العملية الروسية في أوكرانيا، وقائمة الأهداف التي وضعتها موسكو، مع ربطها بتصريحات سابقة للرئيس الروسي، خلال حوار مع إعلاميين في 2018، حين حذّر من التعرّض إلى مصالح بلاده، وهدّد باستخدام السلاح النووي، غير مكترث لما قد يحمله ذلك من تداعيات على العالم، متسائلاً “لماذا نحن بحاجة إلى هذا العالم إن لم تبق روسيا موجودة؟”.
وإذا كانت هذه التصريحات قد قيلت قبل أربع سنوات في ظل توتر سياسي متصاعد بين روسيا والغرب، فإن صداها يتردد اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع تحوّل هذا التوتر إلى مواجهة عسكرية، غير مباشرة حالياً على الأقل، بين موسكو والمعسكر الغربي. ومع أن قوات حلف شمال الأطلسي، أو الدول المنضوية تحت رايته، لم تدخل المعركة بعد، إلا أن مخازن أسلحتها المفتوحة للقوات الأوكرانية والراغبين في مواجهة الغزو الروسي، كان لها الأثر الكبير، إلى اليوم، في صدّ التقدم الروسي باتجاه العاصمة كييف، وتكبيد موسكو خسائر، لم تكن على الأرجح في حسبانها مع بداية المعركة. وبحسب التصريحات والتسريبات التي رافقت انطلاق الحرب قبل نحو عشرة أيام، فإن موسكو كانت تخطط للوصول إلى كييف وتعيين حكومة بديلة هناك في فترة لا تتخطى أسبوعاً. غير أن الحسابات الروسية لم تتطابق مع وقائع المقاومة التي أبدتها القوات الأوكرانية.
وكلما تأخر الحسم الروسي ارتفعت المعنويات الأوكرانية، وهو ما يبدو جليّاً في تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي بدّل خلال الأيام الأولى للحرب خطابه من إعلانه الاستعداد للحياد والتراجع عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي، إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً بمعطيات سياسية وعسكرية تؤشر إلى أن موسكو في موقف لا تحسد عليه.
ولعل مكمن الخطر الأساسي على العالم اليوم هو هذا الموقف الروسي، إذ إن بوتين ينظر حالياً إلى الحملة على أوكرانيا وما يرافقها بأنه معركة وجود حقيقية له كـ”قيصر جديد” ولروسيا كدولة عظمى على الساحة الدولية. وعليه فإن بوتين لن يكون في وارد التراجع عن أي من الأهداف التي وضعها للعملية العسكرية، ولن يتوانى عن استخدام جميع الأدوات التي يملكها للحفاظ على الوجود الروسي.
بوتين اليوم يبدو في وضع مشابه لشمشون في القصة التوراتية، والتي انتهت بهدمه الهيكل على الجميع وفق مقولة “عليّ وعلى أعدائي”. هذه المقولة تتطابق تماما مع تساؤل بوتين عن الحاجة إلى العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه. فالرجل مستعد لتدمير العالم في حال مضى الغرب في خطوات عزل موسكو وإخراجها من المشهد الدولي. وعلى هذا الأساس فإن “الأسوأ قد يكون في الطريق”، والحرب النووية، أو استخدام هذا السلاح، باتا أقرب من أي وقت مضى.
من المؤكد أن هذا التحليل للسلوك الروسي المتوقع يدور في أذهان المسؤولين الغربيين، والذين باتوا قلقين من أخطار المضي أكثر في عزل وإضعاف روسيا. ومن غير المستبعد أن يلجأ الغرب إلى مقايضة ما لمنع الأمور من التدحرج إلى منطقة لا عودة منها، خصوصاً أن بوتين أبدى استعداده لهذه المقايضة، عبر طلب الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم مقابل وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما أبلغه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم تعلّق عليه الدول الغربية.
قد يكون هذا المخرج مناسباً للجميع، ومن الممكن أن تلجأ إليه الدول الغربية قبل أن يأتي الأسوأ ويهدم بوتين الهيكل.
العربي الجديد
——————————-
سُحُب يلتسين التي تمطر في أوكرانيا/ صبحي حديدي
ليس من الإنصاف، بل لعله أقرب إلى الإجحاف، أن تُلقى على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كامل إشكالية روسيا المعاصرة، سواء على أصعدة داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية وإعلامية؛ أو على صعيد الطموحات الجيو – سياسية التي باتت تأخذ صفة تدخل عسكري تارة، أو إلحاق وضمّ واستتباع تارة أخرى. إنه، ليس من ريب كبير، الأكثر تحمّلاً لمسؤوليات قرارات الكرملين في هذه الملفات، والأعلى استعداداً لمجابهة العواقب الوخيمة خلف مغامرات جامحة على شاكلة ما فعل في جورجيا وشبه جزيرة القرم وأوكرانيا راهناً؛ لكنه أشبه بزارع به مسّ، مصاب بخلائط جنون العظمة وشهوة الهيمنة والتماهي المَرَضي مع القياصرة، أورثه آخرون بذار ما يخال أنه يحصد زرعه تباعاً.
وأغلب الظنّ أنّ تاريخ روسيا، وبالتالي تاريخ العالم إبان وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، لم يحفظ للرئيس الروسي الأسبق الروسي بوريس يلتسين (1931-2007) تلك الصورة الأيقونية الشهيرة (في آب/ أغسطس من العام 1991)، أمام البرلمان الروسي، حين امتطى دبابة تابعة لجنرالات الجيش الأحمر الذين أعلنوا الانقلاب على ميخائيل غورباتشيف، قبل أن يفشل انقلابهم على نحو تراجيكوميدي. وليس، غالباً أيضاً، تلك الصورة الأيقونية الأخرى (في تشرين الأوّل/ أكتوبر 1993) حين أمر – باعتباره الرئيس، هذه المرّة، وبعد استدراج ولاء وزارة الداخلية والجيش الروسي – بقصف مبنى البرلمان الروسي ذاته لفضّ نزاع دستوري مع النوّاب المعارضين، على نحو غير بعيد عن الروحية ذاتها: المأساة/ المهزلة.
ما حفظه التاريخ أكثر، بدليل ملفات غوغل وغالبية محركات البحث، هو شريط الفيديو القصير الذي يلتقط الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون عاجزاً عن كتم موجة من الضحك الهستيري انتابته بعد سماع تعليق من يلتسين الواقف إلى جانبه، في نيويورك، خريف 1995. لم يكن المشهد مهيناً ومذلاً وهابطاً، بالنسبة إلى رئيس يتوجب أنه يمثّل القوة الكونية الأعظم الثانية، فحسب؛ بل كان نمط تفضيح أقصى لطبيعة بذور التحريض الشعبوي التي سوف يعتمدها بوتين، ربيبه وخليفته لاحقاً، بصدد إحياء نوستالجيا الإمبراطورية. وقبل بوتين كان هذا المخمور المتهتك، يلتسين، هو الآمر بغزو بلاد الشيشان عسكرياً، وإخضاعها، و«ضرورة قتل الكلاب المسعورة» هناك.
وهذه السطور ليست البتة صيغة مواربة من الحنين إلى النظام السوفييتي؛ بل قد يكون مشروعاً التذكير بأنّ صاحبها ينتمي إلى تيار النقد العميق لماركسية سوفييتية قاصرة وشائهة وستالينية، ولطراز من الاشتراكية استولد موضوعياً سلسلة العناصر التي حتّمت اندثاره. غير أنّ الليبرالية الروسية، الحولاء بدورها والأسوأ تشوّهاً وتسطحاً، كانت ولاّدة صعود حكم الأفراد القلائل المقرّبين من يلتسين، القابضين على زمام الأمور في السياسة الداخلية والأمن والاقتصاد، وأصحاب المصلحة الكبرى في هندسة مستقبل روسيا على نحو آمن خالٍ من العواصف «الديمقراطية».
وقبل الحلقة الضيّقة التي يحيط بوتين نفسه بها، كان يكفي المرء أن يستعرض لائحة أفراد «العائلة» هذه كي يدرك حجم تأثيرها في عقل سيّد الكرملين، الذاهل الذاهب أبعد فأبعد نحو خريف البطريرك: تاتيانا داشنكو (ابنة يلتسين)، ألكسندر فولوشين (رئيس أركان الكرملين)، بوريس بريزوفسكي ورومان أبراموفيتش (أبرز شيوخ المال والأعمال والمصارف). هؤلاء كانوا «القطط السمان» في التعبير الشائع، أو «الأوليغارشية الجديدة» في التعبير الروسي الخاصّ، وكانوا يملكون مفاتيح الجبروت الكبرى: من شركات النفط والصحف اليومية وأقنية التلفزة، إلى مصانع التعدين والأغذية ومؤسسات الاستيراد والتصدير، وصولاً إلى الأهمّ والأخطر: المصارف الخاصّة.
وإذا صحّ أنّ شخصية بوتين حمّالة تعقيدات وعُقُد وعقائد أبعد، بكثير ربما، مما يصحّ أن يُحمّل على شخص يلتسين؛ إلا أنّ علوم الجدل، في حدودها الدنيا، لا تسمح بإغفال تلك الحقيقة البيّنة: سُحُب الأخير هي بعض، غير قليل، من هذه التي تمطر اليوم في أوكرانيا.
القدس العربي
———————————–
عن اهتزاز التوازنات الدولية بعد أوكرانيا/ رانيا مصطفى
فعلها الرئيس الروسي، بوتين، وبدأ حملته ضد أوكرانيا، غير آبه بالعقوبات التي بدأ الغرب بفرضها على بلاده، وهدفه المعلن يتجاوز السيطرة على إقليم دونباس شرقاً، إلى تطويق العاصمة كييف وإسقاط نظامها وتنصيب نظام موالٍ لروسيا، وترسيخ قواعدها العسكرية لحماية هذا النظام؛ فبوتين يعتبر أوكرانيا، إضافة إلى جورجيا وبيلاروسيا وكازاخستان، من ملكياته، ولا يسمح بذهابها باتجاه الغرب، وليس من حق حلف شمال الأطلسي (الناتو) التوسّع شرقاً، ويطالب بسحب قواعد الحلف من الدول التي ضمها، كبولندا ودول البلطيق وغيرها. وهو يجد في حالة الترهل في النظام الدولي فرصة ذهبية لاستعادة مكانة روسيا دولة عظمى، ويعمل، بالقوة العسكرية الفجّة، على امتلاك أوراق تفاوض قوية مع حلف الناتو بشأن إعادة رسم حدود نفوذ الطرفين.
خبر الزعيم الروسي بنفسه محدودية تأثير ردود فعل الغرب، منذ استيلائه على شبه جزيرة القرم في 2014، وكذلك في تمكينه النظام في سورية أمرا واقعا، مخالفاً مقرّرات بيان جنيف 1 بإحداث انتقال سياسي في السلطة، والتي توافق عليها مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في 2012، وقبل ذلك سيطرته على جورجيا في 2008. ولا يشوب فجاجةَ قراراتِه الفردية، أية ديمقراطية أحزابٍ أو حرية رأيٍ أو اعتبارٍ للرأي العام الروسي، كما هو حال خصومه الغربيين. ويبدو كأن هدفه تحقيق طموحه الشخصي بأن يكون رجل روسيا الذي سيعيدها فاعلا أساسيا متحكّما ضمن عالم متعدّد الأقطاب. هذه المغامرة البوتينية لا يكفيها إقدام سيد الكرملين وتصميمه القوي لتؤتي أُكُلَها؛ فمنذ الأيام الأولى، بدا أن أوكرانيا مستنقع جديد ومؤلم لروسيا، وفق ما تظهره مشاهد لجثث آلاف الجنود الروس، بسبب المقاومة التي يبديها الأوكرانيون، حيث يقطن أوكرانيا 46 مليون نسمة، ومعظمهم كاره لروسيا.
استطاع بايدن الضغط على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لتجاوز خلافاته، وتوحيد صفوفه في ما يخصّ الرد على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، حيث يقع على عاتق الجيش الأميركي الدور الأكبر ضمن الحلف في حماية الدول الأوروبية. ويتركز هذا الرد في ثلاثة أمور؛ أولاً، تحويل أوكرانيا إلى مستنقع لروسيا، عبر تقديم الدعم اللوجستي والتسليح الخفيف والقليل من السلاح المتوسط. وبالتالي، إطالة أمد الحرب واستنزاف الجيش الروسي. وثانياً، فرض حصار اقتصادي مشدّد على روسيا، وإقصاء بعض الشركات من نظام سويفت. وبالتالي سيكون هناك هبوط حادّ في قيمة الروبل الروسي في الأشهر المقبلة، ما سينجم عنه بلبلة داخلية، بسبب تصاعد الأزمات المعيشية. وثالثاً، إيقاف طموح بوتين عند حدود أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا، فأوكرانيا ليست ذات أهمية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، بينما هي أولوية بالنسبة لروسيا؛ حيث عزّز الحلف قواته في بولندا ودول البلطيق وباقي الدول التي انضمت إليه، وهذا يعني رفضه المطلب الروسي بانسحابه من الدول المجاورة لروسيا.
تحقيق الغاية الروسية من غزو أوكرانيا مرتبط بسرعة تنفيذه، والحيلولة دون أن يتحوّل البلد إلى مستنقع يطيح كل طموح بوتين، وهذا ما لا يمكن التكهن به. أما اقتصادياً، فقد بدأ منذ احتلاله جزيرة القرم، في 2014، بالاستعداد لهذه اللحظة، حيث حاول تقليص تعامله بالدولار إلى 10%، والتوجه إلى اليورو واليوان الصيني. وفي العام نفسه، وقع مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقداً طويل الأمد لتصدير الغاز إلى الصين، بقيمة 400 مليار دولار، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفي 4 الشهر الماضي (فبراير/ شباط)، وقع مع الصين اتفاقاً آخر طويل الأمد، لمد أنبوب جديد للغاز إلى الصين، وتعهدات بمضاعفة قيمة التبادل التجاري، وهذا يعني أن الصين داعم ضمني لروسيا، وإن كان موقفها السياسي رافض غزو أوكرانيا، ولم تعترف سابقاً بضم روسيا لجزيرة القرم، ولا بجمهوريتي لوغانسك ودونتسيك، ولا ترغب بتضرّر علاقاتها التجارية مع أوروبا، ولا تريد استفزاز الولايات المتحدة. تتفرج على المشهد الأوكراني بشيء من الحيادية، لكنها مهتمة في استثماره لمصلحتها؛ فهي تملك قوة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة وصاعدة، يضاف إلى ذلك صعودها السياسي والعسكري، الأمر الذي تفرّغت الولايات المتحدة للتصدي له منذ سنوات، حيث تركّز الاستراتيجية الأميركية على تكثيف القواعد العسكرية في بحر الباسيفيك قرب الصين، وبناء تحالفات مع الدول المعادية لبكين. على ذلك، تشكلت قناعة أميركية بتجنب التدخل العسكري المباشر في الدول، نظراً إلى الكلفة الهائلة البشرية والاقتصادية التي دفعتها أميركا في الحروب التي خاضها جورج بوش الابن في العراق وأفغانستان، واعتمدت منذ عهد أوباما سياسة الانسحاب من المستنقعات التي غرقت فيها.
من المبكر القول إن غزو روسيا لأوكرانيا نقطة بداية لتشكل نظام عالمي جديد، متعدّد الأطراف، أو بقطب واحد هو الصين؛ لكن الأكيد أن أزمة أوكرانيا أظهرت مدى اهتزاز التوازنات الدولية السابقة، والتي كانت قائمةً على الهيمنة الأميركية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، فالأكيد أن هناك تراجعاً لدور أميركا العالمي، بدأ مع الأزمة المالية العالمية في 2008، وصعود الصين الاقتصادي، وانسحاباتها العسكرية من العراق وأفغانستان، وتركيز وجودها العسكري في الباسيفيك، وتركها سورية لروسيا. وهذا ترتب عليه افتراق مع دول الشرق الأوسط؛ فالعرب يشعرون بالخذلان الأميركي نتيجة غض النظر عن سياسة إيران التوسعية، وإسرائيل غاضبة من العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، وتركيا مختلفة مع واشنطن بشأن ملفات عديدة، أدت إلى تقاربها الأمني والسياسي مع روسيا. وهناك افتراق في المصالح بين واشنطن وأوروبا، المنشغلة بأزماتها الداخلية، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأزمات المالية الناتجة عن جائحة كورونا، وألمانيا لا تستطيع الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية، وهناك علاقاتٌ تجاريةٌ قويةُ بين الاتحاد الأوروبي والصين، والغضب الفرنسي من الولايات المتحدة بسبب حلف أوكوس في استراليا. وهذا يجعل أوروبا تراجع ارتباطها الأمني والعسكري والاقتصادي بالولايات المتحدة؛ فهي أكثر المتضرّرين من أزمة أوكرانيا، في حين أن الروس ستجهدهم الحرب الأوكرانية، وحتى لو انتصروا، سيكونون ضعفاء في التوازنات الجديدة الممكنة. الصين هي الرابح الأكبر، وتتطلّع إلى استثمار ما يجري في أوكرانيا، أياً كانت نتيجته، في بناء تحالفات عالمية جديدة.
العربي الجديد
————————–
عن أولويّات الحرب وفعل المفاجآت الكبرى…/ حازم صاغية
ضدّاً على أساطير كثيرة تسبغ البطولة والنبل على المحاربين، فإنّ الحروب تُخرج من البشر أسوأ ما فيهم. بهذا المعنى، يكسب صاحب التكوين الحربيّ معركة أولى، وإن لم تكن أخيرة، بمجرّد أن يجرّ صاحب التكوين غير الحربيّ إلى الحرب.
إنّه يجرّه إلى سلوكه المفضّل وأرضه المختارة، تماماً كما يكسب مُحبّ العنف جولةً حين يجرّ كاره العنف إلى عراك بالأيدي.
مُحبّ العنف هو الذي تشكّل عبادة القوّة المصدر الأبعد لفكره وسلوكه، وعلى أساس القوّة تنبني سلطته وينهض تنظيمه لمجتمعه. ورغم أنّ حبّ العنف لم يفارق المجتمعات الغربيّة الحديثة، لا سيّما منه العنف الاستعماريّ، ورغم أنّ العنف كان أحد أمتن الجسور التي عبرتها الحداثة إلى حيث انتهت إليه، فإنّ السلطة والمجتمع الديمقراطيّين الراهنين لا يقومان على هذا المبدأ، والأصحّ قوله أنّ كلّ انجرار منهما إلى الحروب كان يضعضع الديمقراطيّة في هذين المجتمع والسلطة. هذا على العكس تماماً من أثر القوّة على السلطة والمجتمع غير الديمقراطيّين اللذين يجدان فيها ما يصلّبهما ويقوّيهما، فيحوّلانها أساساً تنهض عليه وحدة «فولاذيّة» مرتجاة. وحتّى لو كسبت الديمقراطيّة حرباً، وهي غالباً ما تفعل، يبقى أنّها تلعب في غير ملعبها، أو تنجرّ انجراراً إلى ما يُفترض أنّه ملعب الآخرين. هكذا نلاحظ مثلاً أنّ دخول الولايات المتّحدة الحرب العالميّة الثانية جاء بعد «مفاجأة» بيرل هاربور، وهي «المفاجأة» التي عادت لتتكرّر، بزيّ آخر، مع ضربة 11 سبتمبر (أيلول) 2001. أمّا اليوم، مع الحرب الروسيّة في أوكرانيا، فقد أخذت «المفاجأة» أوروبا التي كانت مشغولة بخفض ميزانيّات التسلّح.
وغنيّ عن القول إنّ الذي لا تأخذه المفاجأة هو صاحب المفاجأة وحده.
أمّا التفاجؤ، فإلى صدوره عن التكوين غير الحربيّ لصاحبه، وعن غلبة رهانه على الاقتصاد والبيزنس وتوسيع نطاقهما، ترفده أسباب متفاوتة كثيرة.
فالسياسيّون قد يكونون سذّجاً أو تافهين، أو ما دون الحدث عموماً، وهو احتمال يلازم الأنظمة الديمقراطيّة وبرلماناتها وبعض قادتها. أهمّ من ذلك وأبعد أنّ الغامض وغير المألوف يفاجآن من حيث المبدأ، فيما المجتمع الحديث خصوصاً يحضّ على التفاجؤ بما هو غير مألوف وغامض. بل هو، في تصوّره الخَطّيّ للزمن، وفي توهّمه السيطرة على الحياة، يتفاجأ حتّى بالموت كواقعة لا سيطرة عليها.
والمفاجأة ليس هناك من نظام متّفق عليه في التعامل معها، فضلاً عن أنّ الهزّة التي تُحدثها في الوعي والسلوك تبعث من تحت الأرض قوىً بدائيّة وغرائزيّة ظُنّ أنّ الحضارة المعاصرة قد طوتها. هكذا يظهر فجأةً ما يبدو أخطاءً، بل خطايا، بقياس أزمنة السلم والعاديّة. فهل يُعقَل مثلاً، كما نروح نتساءل، أن تعامل الولايات المتّحدة اليابانيّين المقيمين فيها مثلما عاملتهم فيما كانت تخوض معركة القيم الإنسانيّة الكبرى ضدّ النازيّة، أو أن يُعامَل المسلمون فيها بمثل ما عوملوا بعد 11 أيلول؟
وهل يُعقل اليوم أن تترافق الحرب الدفاعيّة والأخلاقيّة لتحرير أوكرانيا وضمان استقلالها مع إجراءات أوروبيّة وأميركيّة تنطوي على الكثير من العقاب الجماعيّ و«صيد الساحرات»؟ نعم، يُعقل. هذا للأسف ما لا يحدث غيره في الحروب. ومن أجل تقريب الصورة قليلاً، نعود إلى الظروف التي عشناها جميعاً في الخليج وفي العالم العربيّ بعد غزو صدّام حسين دولة الكويت في صيف 1990. يومذاك فوجئ العالم كلّه بالغزو، الذي كان فعلاً أشبه بالضربة الخاطفة (Blitzkrieg).
ولم يكن بلا دلالة أنّ الردّ على الضربة الخاطفة أخذ شكل «عمليّة» (Process) طويلة ومعقّدة، لا تفاجئ أحداً بطبيعتها، لبناء تحالف عسكريّ يعيد إلى الكويت حرّيّتها واستقلالها. لكنْ في هذه الغضون، وفي جميع البلدان العربيّة من غير استثناء، انفجرت موجة من العنصريّات والعنصريّات المضادّة التي دفع الكثيرون ثمنها من حياتهم أو عملهم أو أماكن إقامتهم.
وهي موجة تُدان بقوّة، وتُدان بالطبع، إلاّ أنّ الإدانة لا تتقدّم على إدانة السبب الذي أدّى إليها، أو فجّرها، وهو غزو صدّام حسين للكويت. إدانتها، إلى ذلك، لا تقلب الأولويّات التي يتصدّرها أنّ معركة الكويتيّين كانت حقّاً فيما حرب صدّام بُطل وعدوان.
والشيء نفسه يصحّ في الحروب، أو في أغلبها: ما حدث لليابانيّين وللمسلمين في الولايات المتّحدة معيب وخاطئ ولا أخلاقيّ، لكنّه لا يقلّل من حقّيّة الحرب الأميركيّة ضدّ دول المحور وضدّ بن لادن. ما يفعله بعض الأوكرانيّين وحلفائهم لا يخلو من أخطاء، منها ما هو فادح وكبير. لكنّ معركة الأوكرانيّين، ومعهم الغربيّون، ضدّ الاجتياح الروسيّ تبقى عادلة ومُحقّة وأخلاقيّة.
إنّ من يتفاجأ غالباً ما يكون على حقّ، حتّى لو لم يسْمُ دائماً إلى سويّة حقّه. من يفاجئ غالباً ما يكون معتدياً. المفاجأة، هذه المرّة، ربّما باتت من طبيعة نوويّة تفرض علينا قياس الأحجام والمسؤوليّات بدقّة أكبر!
الشرق الأوسط
———————————
بوتين الرهيب/ بشير البكر
حينما تسربت معلومات أميركية في تشرين الثاني الماضي عن استعدادات روسية لغزو أوكرانيا عسكريا، لم يصدقها أحد، واعتبرها البعض نوعا من المزاح الثقيل، وحتى حين أكدت واشنطن وبعض العواصم الغربية أن الخطة باتت جاهزة ووشيكة، اعتبر قطاع واسع سياسي وإعلامي ذلك نوعا من التهويل الإعلامي والسياسي، هدفه شيطنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يستخدم الحشد العسكري كأداة ضغط فقط، وليس من أجل القيام بعملية عسكرية هدفها “إسقاط الطغمة الحاكمة في كييف”، على حد تعبير فاسيلي نيبنزيا سفير روسيا في مجلس الأمن الدولي، بعد ساعات من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط الماضي.
لم يكن أحد يتوقع حتى وقت قريب أن يقدم بوتين على غزو أوكرانيا، التي تختلف عن جورجيا كثيرا من حيث الجغرافيا والتاريخ، وخصوصا تطورات العقدين الأخيرين في هذا البلد، الذي عرف حراكا ديموقراطيا منذ نحو 15 عاما تتوج في 22 شباط 2014 بقيام البرلمان بخلع الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش، وردت على ذلك روسيا بضم شبه جزيرة القرم. ولم تعرف هذه الدولة بعد ذلك نوعا من الاستقرار، بسبب تدخلات روسيا في إقليم الدونباس الانفصالي، ومع ذلك جرت انتخابات ديموقراطية برلمانية ورئاسية عام 2019، وحاولت السلطات الجديدة إيجاد حل سلمي للأزمة عن طريق “اتفاقات مينسك”، التي هندستها فرنسا وألمانيا.
بوتين وحده لم يعجبه هذا الوضع، إلا أنه لم يكن في حساب أحد أنه يريد تغييره بالقوة، من منطلق أن أوكرانيا جزء من روسيا، كما ورد في خطابه قبل أيام من بدء الحرب. وحتى لو كانت كذلك فليس القوة هي الحل. وكان يمكن أن يطالب بإجراء استفتاء شعبي، تكون نتيجته ملزمة للجميع.
غزو أوكرانيا يقدم بوتين في صورة هتلر جديد في أوروبا، وسواء جرى إعلان ذلك من قبل الغربيين أم لا، فليس هناك شبه لهذا الرجل سوى هتلر، بل هو نسخة معدلة من زعيم النازية. وما قام به من اجتياح عسكري لبلد مستقل صفحة جديدة في تاريخ هذا الرجل الحافل بالمجازر من الشيشان وجورجيا وسوريا، وها هو يفتح الطريق نحو نزاع دموي في أوروبا، ويوجه صفعة إلى الديموقراطيات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة، وإذا مر مشروعه هذا ولم يجد من يقطع الطريق عليه، فإن الأعوام القادمة سوف تكون قاتمة جدا، وستشهد سقوط الديموقراطيات الغربية نحو الحضيض، التي يمثل أحد وجوهها صعود اليمين المتطرف المدعوم من بوتين.
ومنذ اليوم الأول للغزو تصرف الروس، وكأن الحرب محسومة وستكون نزهة سريعة، ولا تصدر عن موسكو سوى بروباغندا بائسة عن أن هدف الحرب هو اجتثاث النازية من أوكرانيا. إن تكرار هذه الجملة من طرف السياسيين والمعلقين الإعلاميين الروس، وحتى بعض مراسلي التلفزة العربية، يكشف عن عدم القدرة على صياغة خطاب متماسك يبرر الحرب، بل طغى خطاب فظ، لغة متعالية، بروباغندا غير مقنعة لأحد، وزير الخارجية سيرغي لافروف ردد عبارة “نازية” كاتهام لسلطات كييف أكثر من عشر مرات في مؤتمر صحفي، في حين أن التوصيف ينطبق على روسيا، التي دفعت بأكثر من 150 ألف جندي لاجتياح دولة مستقلة ذات سيادة تحكمها سلطات منتخبة.
واتضح خلال مجريات الغزو أن هناك مظاهر بارزة عن سطوة المؤسسة الأمنية الروسية، وهيمنة حالة من الخوف الذي يصل حتى تقديس بوتين وترديد كل ما يقوله، وهذا وضع لا مثيل له سوى خلال حكم جوزيف ستالين، ما يعني أن روسيا ستعاني من تداعيات سلبية على وضعها دوليا، رغم أن الموقف الدولي لا يرقى إلى مستوى العدوان، ولكنه مؤثر في اتجاهين. يساعد في شد إزر الأوكرانيين ورفع معنوياتهم. وفضح الغزو الروسي الذي يحظى بمعارضة داخلية روسية.
هدف العملية العسكرية هو “تحرير” العاصمة الأوكرانية كييف من حكامها الحاليين، وإجبار الأوكرانيين على إلقاء السلاح والاستسلام، وبعدها يقرر الرئيس بوتين طريقة التعامل معهم. وهذا ما يلخص المواجهة ويضع الأوكرانيين أمام حرب الاستقلال الفعلي، والتي ستكون دامية، وربما اتسعت نحو أجزاء أخرى من المحيط الجغرافي نحو دول البلطيق وبولونيا. ويعتمد بوتين على انكفاء أميركي وضعف أوروبي، إلا أن الحس الوطني في أوكرانيا كفيل بإسقاط المشروع الروسي الاستعماري.
تلفزيون سوريا
————————
الانحياز للغرب في اوكرانيا..كواجبٍ مؤقت/ ساطع نور الدين
الوقوف مع الغرب، ولو من دون دعوة، في حربه الأوكرانية مع روسيا، جذابٌ ومؤنس، ومحقٌ طبعاً لاعتبارات سياسية واخلاقية وانسانية لا جدال فيها. لكنه ليس مجدياً، لأنه لا يزيل حواجز عدم الثقة، ولن يخدم أي قضية خارج المجال الاوروبي، ولن يسهم في مزاعم الاندماج في الثقافة الغربية.. التي تتطلب هي نفسها، الحوار والانتقاد، بل تسمح بإعلان الحياد، بقدر ما تنادي بالانخراط في الحرب.
التواضع شرط ضروري للمضي في الدفاع عن هذا “الانحياز” لطرف كانت معاداته ومخاصمته من الاسس الصلبة لثقافة العالم الثالث كله، وليس فقط العالم العربي او الاسلامي. وكذا الامر بالنسبة الى روسيا التي كانت حتى الامس القريب حليف العرب وشريكهم في حروبهم، قبل ان تصبح عدو شعوبهم الراغبة بالحرية والديموقراطية، كما كانت خصم الشعب الاوكراني وثورته البرتقالية، وقبل ان تتوج على رأس الدول المدافعة عن أنظمة الاستبداد والفساد العربيين.
أما بالنسبة الى اوروبا، وهي أقرب الى العرب والمسلمين من روسيا، في الجغرافيا وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الثقافة طبعا، فإن الوقوف معها يكاد يرقى الى مستوى الواجب، حتى ولو لم تسترد القارة العجوز قيادة الحرب مع روسيا من الاميركيين، الذين يمكن أن ينزعوا عن تلك الحرب أهدافها الانسانية”النبيلة”الخاصة بحماية الشعب الاوكراني وحقه بالحرية والاستقلال والديموقراطية، ويدرجونها في سياق حروبهم المقبلة مع الصين في وقت لاحق من القرن الحالي.
وليس من قبيل المجازفة القول ان الانحياز في الحرب الاوكرانية الى جانب الطرف الضعيف، مؤقت، لأن موازين القوى يمكن ان تنقلب رأساً على عقب، إذا ما تبين فعلا بأن الجيش الروسي ليس بالقوة التي تروج عنه، (عدا اسلحته النووية)، وإذا ما انتصرت المقاومة الاوكرانية، او على الاقل تمكنت من تحويل بلادها الى افغانستان ثانية..بدعم عسكري وسياسي غير مسبوق من حلف شمال الاطلسي.
لكن، ومهما كان المدى الزمني المفترض للانحياز الحالي، فان التواضع يستدعي الاقرار أيضاً بانه لن يغير شيئاً من موازين القوى، ولن يؤثر في مواقف المتحاربين الكبار. وعليه يصبح الموقف، الرسمي والشعبي، مجرد رأي أو إنطباع أو تعبير متداول في الفضاء، تسمح به حقوق النشر الخاصة بوقائع الحرب الاوكرانية الطاحنة، وحقوق المشاهدة المتاحة بالمجان للملايين من سكان العالم، الذين يتسمون هذه الايام امام شاشات التلفزيون او الكومبيوتر او التلفون.
في صور الحرب الاوكرانية وتفاصيلها، الكثير مما يمكن ان يقال عن أوجه شبه واختلاف مع حروب الشوارع في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا..لكنه لا يساعد في فهم الموقف الروسي ولا في تفسير الموقف الاوروبي ولا في تفهم الموقف الاميركي. المدنيون الاوكرانيون الذين يتساقطون اليوم، او الذين يفرون من بلدهم، هم الاصل وهم المعيار الاهم للحكم على الحرب والمبرر الاقوى للانحياز الى جانب أولئك الضحايا الابرياء.
يضاف الى ذلك مبرر حاسم، هو ان روسيا التي تحولت الى دولة خطرة يمتد تهديدها الى العالم العربي، بقدر ما يستهدف محيطها الاوروبي المباشر، قدمت مثالاً فظاً على أنها أصبحت دولة قاهرة، عندما قررت أن تطيل عمر النظام السوري وتمدد بالتالي عمر الحرب السورية وعذابات السوريين المقيمين والمهجرين، وتستخدم لذلك قوة عسكرية تكاد توازي تلك التي تستخدمها ضد الشعب الاوكراني، وتجعل الحملة العسكرية الروسية على سوريا المستمرة منذ سبع سنوات، تبدو أشبه بمناورة بالذخيرة الحية مهدت للحرب الحالية ضد أوكرانيا.
هذا النموذج للسلوك الروسي المدمّر في سوريا، الذي واكبته تجارب مماثلة في مصر والعراق وليبيا..يقوي حجة الوقوف مع الغرب، ودعوى الالتحاق ب”الأخيار”، ولو بشكل مؤقت، وعابر، وحتى من دون تلقي أي طلبٍ أو أي إذنٍ غربي.
——————————–
أوكرانيا: العالم أمام فوهة الهاوية/ حسام عيتاني
يدور همس بين الخبراء الغربيين في السياسة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيضغط زر إطلاق الأسلحة النووية إذا شعر أنه يقترب من هزيمة محققة في أوكرانيا.
ورغم أن الحرب الحالية والأزمة السابقة عليها توفران الشواهد الكافية للاعتقاد أن حصر ما يجري هناك بمخاوف موسكو من تمدد حلف شمال الأطلسي وتهديده الأمن الروسي، لا تكفي لوضع هذا التطور العالمي في سياقه السليم. ذاك أن المسألة لا ترتبط بالسلامة العقلية لبوتين، أو بمستوى التضليل الذي تمارسه وسائل الدعاية التابعة له ضد الجمهور الروسي ذاته. بل إن الأمر يصل إلى رؤية قيامية (أبوكاليبسية) لا ترى فائدة من وجود العالم أصلاً إذا كانت روسيا فيه ذليلة وتابعة.
تدمير أوكرانيا من وجهة النظر هذه، أسهل من تسليمها إلى الغرب الذي سيستغلها لتطويق روسيا وفرض معادلات جديدة هدفها إعادة موسكو إلى ما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي: أرض للفوضى تديرها عصابات إجرامية. دعونا من صحة بوتين النفسية قليلاً، ولنتفق أن الرواية الروسية التي لا تفتقر إلى مؤيدين، تقوم على أن الرئيس الحالي استعاد بعض المكانة لروسيا على الساحة الدولية. هل ينتمي هذا النوع من التفكير إلى القرن التاسع عشر؟ هل تشكل السلطة في روسيا «مافيا المافيات» بقيادة «زعيم زعماء المافيا» بوتين؟ يقلل أصحاب الرواية المذكورة من أهمية هذين السؤالين، ليؤكدوا أن الغرب ما زال يفشل في الاعتراف أن عقد التسعينات قد انتهى، وأن لروسيا مجموعة من القيم لا تتفق مع مدونة السلوك الغربية. من القيم هذه أن القوة وسيلة مقبولة لتحقيق الغايات، حتى لو تتدثر بقرارات مجلس الأمن الدولي على النحو الذي تفعله الولايات المتحدة عندما تريد أن تغزو العراق أو أفغانستان، على سبيل المثال. ويتابعون أن التشكيك في شرعية الحكم الحالي في روسيا تارة، وبسلامة بوتين العقلية تارة أخرى، لن تفضي إلى مكان. وأن على الغرب التعامل مع السلطة في موسكو كسلطة شرعية، ما دام المواطنون الروس لم ينتفضوا عليها.
الحل المقبول من وجهة النظر الروسية هو منح منطقتي دونباس ولوغانسك حكماً ذاتياً موسعاً، حسب ما تنص عليه اتفاقيات مينسك التي لم تلتزم كييف بها، وحصول هاتين المنطقتين على حق النقض فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ضمن بنية فيدرالية للدولة الأوكرانية. وينبغي أن تكون هذه محايدة حيال القوى الكبرى، بل حتى خارج الاتحاد الأوروبي لما يتطلبه الانضمام إليه من تغييرات بنيوية في سياسة الدولة لا تتفق مع توجهات موسكو.
وتسود في الأوساط المحافظة الأميركية قراءة تقوم على أن لا قيمة لأوكرانيا بالنسبة إلى الغرب. من وجهة النظر الاستراتيجية، لا توفر أوكرانيا أي إضافة لأمن أوروبا والولايات المتحدة حيال أي تهديد. أما اقتصادياً، فهي دولة فقيرة لم تستطع بعد الخروج من الإرث السوفياتي فيما ترك الفساد الذي ينخرها منذ ثلاثين عاماً آثاراً لا تُمحى على كل مؤسساتها. كذلك، لا تتمتع أوكرانيا بثقل ثقافي باستثناء احتوائها على بعض التراث الكنسي الأرثوذكسي.
تمضي القراءة، التي تستشهد بتصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين، إلى أن واشنطن تتمسك بـ«عقيدة مونرو» وتعض عليها بالنواجذ. خلاصة العقيدة هذه التي شرحها الرئيس جيمس مونرو، في رسالة إلى الكونغرس سنة 1823، أن الولايات المتحدة لن تسمح للدول الأوروبية باحتلال المزيد من المستعمرات في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وأنها ستقاوم كذلك قيام «الدول الدمى» التابعة للإمبراطوريات الأوروبية. بمرور الزمن، فقدت العقيدة مضمونها «التحرري» – إذا صح التعبير – وباتت تُستخدم كإحدى مسلمات السياسة الخارجية الأميركية التي تجعل من النصف الغربي من العالم «حديقة خلفية للعم سام». على خلفية العقيدة هذه، جرت أزمة الصواريخ الكوبية في 1962، لم يكن من المقبول في العقل السياسي الأميركي نشر قوات سوفياتية، ناهيك عن أنها مسلحة بصواريخ نووية، على بعد تسعين كيلومتراً عن أراضي الولايات المتحدة. السؤال الذي يطرحه بعض الباحثين المحافظين الأميركيين اليوم، هو لماذا على روسيا أن تقبل بقيام «كوبا أميركية» على حدودها ما دامت أوكرانيا لا قيمة استراتيجية لها بالنسبة إلى الأمن الأميركي؟
المشكلة فيما تقدم هو اعتماده تصورين اثنين للقضية الأوكرانية. أميركي وروسي. في حين أن للأزمة الراهنة وعلى غرار كل القضايا الكبيرة في العالم، وجوهاً شتى. وأحد هذه الوجوه هو الوجه الأوكراني.
ثمة 44 مليون أوكراني لم يُسألوا عن رأيهم في التصورات والحلول المقترحة. هناك من يتساءل: لماذا لا يقبل الأوكرانيون بالحياد ويطالبون عبر حكومتهم المنتخبة بالانضمام إلى الغرب والحلف الأطلسي؟ وما هي المشكلة إذا خضعت أوكرانيا هذه المرة أيضاً للنفوذ الروسي لتتجنب دماراً ناجزاً ونهائياً؟ جواب الأوكرانيين أنهم جربوا هذه الاقتراحات لفترات طويلة لا تقتصر على الحقبة السوفياتية. فقسم كبير من زمن استقلالهم كانوا فيه تحت حكم أنصار وتابعين ومؤيدين لروسيا، آخرهم فكتور يانوكوفيتش الذي مزج الليونة أمام المطالب الروسية بالفساد والرشوة على غرار من سبقوه، ما خلف مرارة مزدوجة من التبعية لموسكو ومن الفقر الشامل، قبل أن يفر إلى روسيا هرباً من ثورة شعبه.
المقاومة الأوكرانية التي تحتفل وسائل الإعلام الغربية حالياً بها، قد لا تكون سوى مقدمة لمواجهة عالمية يتهرب الغرب منها حتى الآن. بيد أن انكسار المقاومة هذه مثله مثل انتصارها قد يضع العالم أمام فوهة الهاوية. لم تكن المحرقة النووية واقعية أكثر من اليوم.
الشرق الأوسط
————————-
مقدمات المشهد العالمي الراهن… ما الذي خلق الأزمة الأوكرانية؟/ محمد بدر الدين زايد
تتواصل فصول الأزمة الأوكرانية بتعقيداتها وخطورتها، ولقد توقعنا وكثيرون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتراجع عن حافة الهاوية، ومع انشغال العالم بمآلات الأمور وكيف ستؤثر هذه المسألة وانعكاساتها في الأطراف المعنية، وفي الاقتصاد العالمي، وطبعاً تأثيرها في المنطقة العربية وبلادنا، أعتقد أن هناك سؤالاً ضرورياً ومنطقياً، وهو ما الذي أوصل الأمور إلى ما أصبحت عليه؟
وهنا، نرى ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي الخلل المزمن في النظام الدولي الأممي، وسياسات المعايير المزدوجة العالمية والغربية بشكل خاص، واستمرار غلبة القوة على العدالة.
خلل النظام الدولي الأممي
أو لنقل الخلل في منظومة الأمم المتحدة، وهدفها الرئيس حفظ السلم والأمن الدوليين، والخلل المزمن في القانون الدولي بشقيه التقليدي والإنساني، عاشت البشرية أحلاماً منذ أطلق عدد من المفكرين أفكاراً حول إقامة نظام قانوني وفكري دولي أكثر عدلاً قائم على عدد من المفاهيم والقيم السامية، حاول بعدها وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى ترجمتها إلى ما عرف بعصبة الأمم، التي انهارت لأسباب محلها دراسات التاريخ والعلاقات الدولية، وبعد معاناة البشرية واندلاع الحرب العالمية الثانية، التي حصدت الملايين من أغلب شعوب العالم، حاول العالم إصلاح الأخطاء السابقة وإنشاء منظمة الأمم المتحدة، التي أفردت الجزء الأكبر من مهمتها لحفظ السلم والأمن الدوليين، لكن المنظمة نجحت في حالات محدودة وأخفقت في الجانب الأكبر من مهمتها. والمعروف أن أهم أسباب الإخفاق حق الفيتو للخمس الكبار والحرب الباردة التي شلت المنظمة، ومنعتها من أداء عملها بصرف النظر عن مدى صحة تحركها من حين إلى آخر.
وفي مرحلة هيمنة الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، كان نجاح المنظمة رهناً بإرادة واشنطن وتوجهاتها، كما وصفها بدقة المفكر والدبلوماسي المحترف الراحل بطرس غالي، في كتابه “بيت من زجاج” عن تجربته كأمين للمنظمة الدولية، ففي هذه المرحلة كانت الأمم المتحدة تسير بإرادة واشنطن.
وبعد التراجع التدريجي لهيمنة واشنطن عاد الركود التدريجي للمنظمة وعجزها عن القيام بمهمتها بشكل جاد، لم تستطع الأمم المتحدة منع غزو العراق رغم معارضة أغلب دول العالم، ولم تستطع تحقيق أي نجاح حقيقي في تسوية أغلب الأزمات الدولية في العقدين الأخيرين، بل كان تدخلها في أزمة مثل ليبيا مصدراً إضافياً للتعقيد، كون هذا التدخل مدفوعاً بسيطرة غربية مشوهة بتنافسات دولية أضفت على هذا التدخل سمات سلبية عديدة.
ومن دون شك كان للأمم المتحدة دور مهم في قضايا الإغاثة الإنسانية والتنمية في كثير من دول العالم، لكنه دور مع أهميته لا يلغي الدور الرئيس الذي أنشئت من أجله، كما أنه من الأمانة ملاحظة أن المنظمة تخضع لسيطرة غربية واضحة في كثير من مجالات عملها، ليس فقط لأن ثلاث دول غربية من الخمس الكبار، أي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، إنما أيضاً بسبب التمويل، ولهذا قصة كبيرة، على أن هذه السيطرة لا تعفي كلاً من روسيا والصين من مسؤوليتهما المشتركة مع باقي الخمس الكبار عن المشاركة في إحداث هذا الخلل المزمن في المنظمة.
المعايير المزدوجة
تدمن البشرية تاريخياً المعايير المزدوجة، ويستحل البشر لأنفسهم ما لا يقبلونه لغيرهم، وفي عالم الدول تزداد حدة هذه المسألة بشكل خطير، ولا حدود للكذب والنفاق، بل نادراً ما تتفق الدول على ما هو عدل، وما هو غير ذلك، وللدول الغربية هنا باع طويل لا أظن أن سجل أحد ينافسها في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال ومع تحفظي على كثير من السياسات الروسية، أخيراً، فقد أثرت وكثيرون أزمة الصواريخ الكوبية، وأن دروس هذه الأزمة كان يجب تذكرها قبل هذا التصعيد، وكان من الممكن احتواء وإفشال التحرك الروسي ومساعدتها على الخروج من ورطة حافة الهاوية، عموماً لن أعيد هنا ما ذكرته وكثيرون حول تفاصيل هذه الأزمة.
لكن ما يعنينا هو المشهد الكلي الذي يزج فيه بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكي أكون واضحاً لست من المعجبين بالنظام السياسي الروسي على الإطلاق، لكن أشير إلى ما اعتاد كثيرون قوله للأصدقاء الغربيين من دبلوماسيين وباحثين، إنه طالما استمر الظلم الأميركي والإسرائيلي للشعب الفلسطيني بصمت غربي، ورغم كل مساعداتهم الإنسانية لهذا الشعب، فإن هناك مشكلة مصداقية عميقة، وطالما نلاحظ اختلاف مواقفهم من الدول بحسب مصالحهم المتغيرة من وقت إلى آخر، رغم أن ممارسات نظم هذه الدول هي نفسها.
القوة فوق العدل
الفوضى والحرب كأداة لتغيير النظام الدولي، وهي النتيجة الطبيعية للبعدين السابقين، بحيث تصبح الغلبة في هذا العالم للقوة، والقوة هنا نسبية وشاملة، فليس معنى أن روسيا أقوى عسكرياً أنها ستفوز في النهاية، فربما يهزمها الاقتصاد مرة أخرى، علماً أنني لا أريد مناقشة هذا الآن، فالأمر بالغ التعقيد، فقط أذكّر بما أطرحه منذ عدة سنوات بأننا نعيش في عالم قيد التشكل، ولم تتضح أبعاده بعد.
والشاهد أنه وبصرف النظر عن ناتج هذه الحرب تواصل البشرية خطيئتها التاريخية بأن تكون الحروب والدمار أداتها لصياغة النظام الدولي، ويستشهد كثير من المفكرين والباحثين في مجال الاستراتيجية أن صناعة التحولات الدولية تجري دوماً بالحروب، كان هذا هو حال العالم القديم، ثم في العصور الوسطى، ثم كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية، وبعد هذه الثانية توهم العالم أنه نجح، أخيراً، في صياغة ترتيبات رشيدة، وهو ما لم يحدث كما أشرنا من قبل، وفي البداية غرق العالم في حروب الوكالة والحرب الباردة حتى سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار حلف وارسو.
لكن، ما حدث بعد ذلك وبدأ بغزو العراق للكويت عبر عن بعدين رئيسيين، الأول أن دولة ما- أي العراق- تتصور أن الظروف الدولية تسمح لها بابتلاع دولة أخرى ونعود لما قبل الحرب العالمية الثانية، والثاني أن الدولة العظمى أي الولايات المتحدة تستغل هذا الأمر لقيادة حرب مفهومة وعادلة، لكنها توظفها بطريقة ترسخ بها هيمنتها على النظام الدولي.
ثم كانت محطات وحروب عديدة في العقد الأخير من القرن الماضي، ثم حرب غزو أفغانستان التي كان لها دوافعها المفهومة، لكن واشنطن في سبيلها لتأكيد هيمنتها قامت بعد ذلك بأعوام قليلة بجريمة غزو العراق، المبنية على أكاذيب كبرى، التي فتحت الباب لانهيار هذه الدولة وتغلغل إيران، وفي جميع الأحوال استمر العالم في الاعتماد على الحروب، لبناء مصالحه الخارجية، بل جرى استغلال اختلال عدد من النظم السياسية في العالم، بخاصة في المنطقة العربية، كذريعة لتدخلات عسكرية واستخدام هذه الصراعات، بخاصة في سوريا واليمن وليبيا، لتعظيم مصالح أطراف دولية وإقليمية.
ليست هذه محاولة لطرح رؤية مثالية، لكن لتوضيح أنه نتيجة للاختلالات الهيكلية المتواصلة في بنية المجتمع الدولي، ما زالت دول العالم تجد الحروب هي الوسيلة الرئيسة لحماية المصالح والمكانة السياسية، والواضح أن العالم سيواصل تفاعلاته في ظل هذا الخلل المزمن، ومن ثم لا محل لأوهام فيما هو قادم، فمظاهر الخلل المزمنة لا يتم علاجها والتشوه سيستمر، وستستمر معاناة الشعوب من هذه الحماقة المزمنة.
—————————-
أمريكا للمعارضة السورية: لا تصعيد ضد روسيا اذهبوا إلى اللجنة الدستورية!/ منهل باريش
لا يمكن للمعارضة السورية التصرف خارج مصلحة أنقرة في الأحوال العادية، فكيف بمرحلة حرجة للغاية تحاول تركيا الحفاظ على توازن العلاقات وكسب ود ورضا الدولتين المتحاربتين في آن معاً.
في الوقت الذي تحلم فيه المعارضة السورية أن تتلقى دعما عسكريا غربياً، أمريكيا على وجه الخصوص، أيقظهم من أضغاث أحلامهم بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، عقب اجتماع «أصدقاء سوريا» في واشنطن الخميس، على مستوى المبعوثين، ضم ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وتركيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والعراق والأردن وقطر والسعودية، كما حضر ممثل عن جامعة الدول العربية وآخر عن الاتحاد الأوروبي.
وعوضا عن رغبة المعارضة بسماع أخبار منتظرة من نوع «تزويد المعارضة بصواريخ ستنغر وجافلين» على غرار ما يحصل في أوكرانيا، حث بيان المتحدث على «وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. واحترام القانون الإنساني الدولي، والتشديد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق».
ولم تنته الخيبات من البيان عند ذلك، بل كرر موقف بلاده المرحبة بمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، المعروفة «خطوة بخطوة» وأشار مكتب المبعوث إلى انتظاره التوصل إلى «نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة للجنة الدستورية السورية في آذار الجاري» مؤكداً على أن الدول المجتمعة «ستواصل الضغط من أجل المساءلة، خاصة بالنسبة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية». ويؤكد البيان على ملف المساءلة وإطلاق سراح المعتقلين والحل السياسي بناء على قرار مجلس الأمن 2254. وتشير انتظارات الموقف الأمريكي إلى أنه لا توجد رغبة لدى الأمريكان بتغيير المسار السوري أو الضغط على موسكو بما يتعلق بكل المسارات وعلى رأسها المسار الدستوري الذي لم يتقدم قيد أَنمُلة منذ عقد جولته الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
وفي أول تعليق للمعارضة السورية على نتائج اجتماع دول «الأصدقاء» قال رئيس «الائتلاف الوطني» سالم المسلط: «نقدّر التوقيت في ظل انشغال العالم بأزمة أوكرانيا، كانت رسالة إيجابية من طرف أصدقائنا مفادها أن القضية السورية ما زالت موضع اهتمامهم، لكن ما نتج كان دون تطلعات السوريين». وزاد «يتعرض شعبنا للإبادة والتهجير ولا تفيد اللغة المخففة في رفع المعاناة عنه، نظام الأسد وحلفاؤه يجب أن يُشار لهم بالاسم ويُسلط الضوء على جرائمهم ويُرفع عنهم كل غطاء ويساقوا إلى المحاكم الدولية».
وفي إطار استغلال العدوان الروسي، اقتصر تحرك المعارضة السورية على زيارة تضامن، قام بها دبلوماسيو السفارة السورية في قطر وممثلون عن الجالية السورية إلى السفارة الأوكرانية في العاصمة الدوحة، وكان في استقبالهم السفير أندري كوزمينكو. ورغم أهمية التحرك فانه بعيد كثيرا عن منطقة الحساسيات الأخرى، مثل تركيا وأبو ظبي والرياض والقاهرة والتي لديها الكثير من الحسابات الدقيقة بين روسيا وأمريكا. واكتفت المعارضة «الرسمية» بإصدار بعض التصريحات التي أعربت فيها عن إدانتها للغزو الروسي، أما على الصعيد الدبلوماسي فلم تقم بأي زيارة دولية خصوصا إلى عواصم الدول التي تقود حملة التصدي لروسيا مثل لندن وواشنطن أو باقي الدول الأوروبية المهددة مباشرة. وعوضاً عن ذلك، فضلت قيادة «الائتلاف الوطني» زيارة تل أبيض ورأس العين.
وفي السياق، يستمر النقاش السوري حول مسألة الدور المحتمل للمعارضة ويشغل بال الباحثين والسياسيين والنشطاء الذين يجدون في الغزو الروسي لأوكرانيا فرصة لتغيير الموقف مع النظام في سوريا، بمعنى توسيع دائرة الصراع والمواجهة الغربية لروسيا وتوسيع الجبهة إلى سوريا وإعادة القتال إلى سوريا مرة أخرى.
ويسيطر هاجس «تصنيع المعارضة» في حال اعتقدت الدول الغربية الفاعلة بضرورة نقل المعركة ضد الرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا. وهي التجربة التي حصلت مع عدة معارضات، أبرزها المعارضة العراقية ضد نظام صدام حسين. وهي «النظرية» التي يؤمن بها عدد غير قليل من السوريين، لكن السبب هو عدم وجود إرادة فعلية غربية بتغيير النظام السوري. وتريح هذه الفكرة ضمائر المعارضة وتبرر الفشل والتقاعس المستمرين، فتستمر بثباتها حتى يأتي الربيع الأمريكي.
وترتبط المعارضة السورية بموقف تركيا أولا وأخيراً. ولا يمكنها بطبيعة الحال التصرف خارج مصلحة أنقرة في الأحوال العادية، فكيف بمرحلة حرجة للغاية تحاول تركيا الحفاظ على توازن العلاقات وكسب ود ورضا الدولتين المتحاربتين في آن معاً.
وتدير أنقرة علاقة معقدة مع موسكو مبنية على فصل الملفات في سوريا وليبيا والقرم وأخيرا في أوكرانيا، في حين تتعاون الدولتان بقضايا الأمن والسياحة والغاز والمفاعل النووي لأغراض مدنية ومنظومة إس- 400.
وأغلقت تركيا مضيق البوسفور الواصل إلى البحر الأسود أمام السفن العسكرية، بناءً على طلب من كييف وحلف شمال الأطلسي «الناتو» معتمدة على اتفاقية مونترو لعام 1936 ولكن إغلاق المضيق أتى بعد عودة أغلب السفن إلى قواعدها الروسية في البحر الأسود بعد انتهاء التدريبات في البحر المتوسط عشية بدء الغزو، وهي في الأساس تعبير عن تضامن رمزي مع الناتو، ولن تؤثر على المعركة في أوكرانيا.
وفي الوقت الذي رفضت فيه أنقرة العقوبات على موسكو واستمرت في فتح المجال الجوي أمام الطيران الروسي المدني والعسكري سلمت دفعة جديدة من طائرات بيرقدار قبل يومين لكييف.
في المقابل، فإنه من المتوقع بعد سيطرة الجيش الروسي على المدن الأوكرانية الكبرى أن تستمر الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي بدعم المقاومة الأوكرانية وإدخال الروس بحرب استنزاف طويلة تحول أوكرانيا إلى مستنقع فعلي كما جرى عندما غزا الاتحاد السوفييتي جارته أفغانستان، تحولت الجبال الواسعة إلى مستنقع استنزف فيه الجيش الأحمر عشر سنوات، انتهت بهزيمته وخروجه في شباط (فبراير) 1989.
وينعكس استمرار الحرب مع الوقت بشكل سلبي على العلاقة مع دول الشرق الأوسط بما فيها تركيا وإسرائيل، ومن المرجح أن تتضرر العلاقة الأمريكية مع السعودية والإمارات إلا في حال عوضت النقص الحاصل في سوق النفط عوضا عن النفط الروسي. لكن تبقى دول الخليج المصدرة لمصادر الطاقة هي أكثر الرابحين اقتصاديا من الأزمة الأوكرانية بسبب زيادة الطلب على الغاز والنفط من دول الخليج العربي، وكذلك سيكون حال إيران أيضا، فهي اكثر الرابحين على الإطلاق مع خروجها من نفق العقوبات الطويل.
ختاماً يختصر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ستولتنبرغ مستقبل الحرب في أوكرانيا بقوله «الحلفاء رفضوا طلب كييف فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لا يجب أن تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها، الناتو لا يسعى لحرب مع روسيا وليس جزءا من هذا النزاع». وهذا يعني أن الحرب ضد روسيا ستبقى ضمن الحدود الأوكرانية فقط. ولكن دعم الحلف وشركائه مستمر إلى كييف وهو تحضير لمواجهة طويلة لن تنتهي قريباً، فقد بدأها الرئيس بوتين ولن يتمكن من وضع خاتمتها سريعاً.
القدس العربي
——————————
أوروبا تستبدل المواجهة المباشرة مع بوتين بـ«حرب استنزاف» في أوكرانيا!/ رلى موفّق
دخل غزو روسيا لأوكرانيا أسبوعه الثاني. الضوء الأخضر الأمريكي لتوغّل روسي على نطاق صغير كان قد أعطاه سيد «البيت الأبيض» لـ«قيصر الكرملين» في إيحاء أن رد «الناتو» سيكون على قدر التمادي في خرق الخطوط الحمر. ستكثر القراءات مستقبلاً عما إذا كان جو بايدن بتصريحه ذلك، قبل أسابيع، قد نصب «الفخ» لفلاديمير بوتين، فجرى استدراج «الدب الروسي» إلى وحول حرب على أسواره ستكون حرب استنزاف طويلة وموجعة، وستُرخي بظلالها على مستقبل روسيا الاتحادية تماماً كما انعكست حرب أفغانستان الأولى بتداعياتها على الاتحاد السوفييتي.
بدأ الحديث عما إذا كان التاريخ سيكرِّر نفسه، فيرجع العالم إلى زمن «الحرب الباردة» وإلى ما قبل سقوط جدار برلين، بحيث يُصبح هناك جدار كييف، وأوكرانيا الشرقية والغربية كما ألمانيا الشرقية والغربية، واستبياناً العودة إلى زمن المعسكرين الشرقي والغربي في نهاية الحقبة الأحادية التي تزعمتها الولايات المتحدة ما بعد نهاية «الحرب الباردة».
يضع بوتين جملة شروط تتعلق بالشرق الأوكراني الذي يغزوه من محاور عدّة، ويعمل على التقدّم إلى كييف حتى نهر الدنيبر الذي يُشكِّل خطاً فاصلاً بين الضفتين الشرقية والغربية للعاصمة التي تربط بينهما الجسور. يُلوِّح منظرو روسيا بأن إغضاب «سيد الكرملين» قد يدفع به إلى احتلال منطقة غرب أوكرانيا أيضاً، والذي تقتصر مطالبته اليوم بأن تنتهج الحياد والالتزام بعدم الانضمام إلى الحلف الأطلسي. يأخذ النقاش مجرى أن مصير الشرق الأوكراني مُنتهي. ولو كانت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون غير موافقين ضمناً على سقوطه في الفلك الروسي لكانت قوات «الناتو» أضحت في قلب كييف. فالعقوبات وحدها يمكنها أن تُشذِّب شكل الالتحاق لا أن تمنعه.
يُجادل المنظرون بأن نظاماً عالمياً جديداً يتشكّل راهناً على رقعة الشطرنج الأوكرانية. سيتجلّى الصراع أكثر فأكثر بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي. اليوم أضحى مستقبل أوروبا على المحك بعدما باتت في قلب الحرب، وستحدد تطوراتها مدى انخراطها المباشر فيها. وحّد بوتين أوروبا بقوة ودفعها من جديد إلى حضن الولايات المتحدة الأمريكية بعد رهانات على الوهن الذي يُصيب الاتحاد الأوروبي وينسحب على الحلف العسكري الذي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرى عدم جدوى بقائه، فإذا بدوله اليوم ترفع من موازناتها العسكرية وتستشعر بالخطر المحدق بها وتدخل على خط المعركة تسليحاً للقوات الأوكرانية بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، حتى إن السويد وفنلندا خرجتا عن حيادهما وأرسلتا دعماً عسكرياً هو الأول لدولة أخرى منذ عقود، وكذلك فعلت ألمانيا التي كانت تبتعد عن تزويد مناطق الصراع بالأسلحة، وذهبت إلى اتخاذ قرار استراتيجي برفع موازنة إنفاقها الدفاعي عبر تخصيص مئة مليار يورو لصندوق خاص لقواتها المسلحة.
في التقارير لمراسلين حربيين داخل أوكرانيا أن 30 مقاتلة و40 مروحية روسية قد تحطمت حتى الرابع من آذار/مارس الحالي على أيدي القوات الأوكرانية منذ الرابع والعشرين من شباط/فبراير تاريخ بدء الغزو. وتُظهر الفيديوهات والصور المنقولة من الداخل حجم الاستهداف الكبير للآليات والمدرعات الغازية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 498 جندياً روسياً وإصابة 1597 في الأسبوع الأول من بدء العملية العسكرية، وهو رقم ليس بسيطاً رغم الاعتقاد السائد بأنه لا يعكس حقيقة حجم الخسائر الروسية التي تقول كييف إنها بالآلاف.
ما تعكسه نوعية السلاح الذي يُرسل من الغرب إلى أوكرانيا (صواريخ ستينغر وجافلين ولاو) وإنشاء فيلق للمقاتلين الأجانب، يُشير إلى أن هذا البلد يُحضِّر لحرب طويلة على شكل حرب عصابات ضد الروس الذين سينجحون، عاجلاً أم آجلاً، في احتلال جزءٍ واسع من الأراضي الأوكرانية في ظل الاختلال في القدرات العسكرية بين البلدين، مع قرار «الناتو» عدم الاحتكاك المباشر مع الروس تجنباً لمستوى آخر من التصعيد يُفتح الباب على حرب عالمية ثالثة لن يكون السلاح النووي بعيداً عنها، ولا سيما أن بوتين، بعدما لوَّح مراراً بإمكان اللجوء إلى هكذا خيار، طلب من جيشه وضع «قوات الردع النووي» في حالة تأهب في رسالة تهديد علنية ومباشرة للعالم، بأنه عازم على «الانتحار الجماعي» إن لم يستجبْ الغرب لمطالبه، في ما يعتبره حماية أمنه القومي والاستراتيجي.
لا يقف طلب بويتن عند ضمان عدم دخول أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، ولا عند التزام «الناتو» بعدم التوسّع شرقاً، بل يُريد تراجعه عن تواجده العسكري في شرق ووسط أوروبا، وعودته إلى ما كان عليه قبل 1997 قبل التحاق دول من أوروبا الشرقية به، وهنا بيت القصيد. فقبل الإيغال في تحديد مرامي الولايات المتحدة الأمريكية الكامنة في إضعاف روسيا وإشغالها وعزلها ليسهل عليها إدارة مواجهتها مع الصين في معركة تقليم أظفار «التنين الأصفر»، فإن القلق اليوم مشروع لدى دول الاتحاد السوفييتي السابق التي استقلّت، وخصوصاً دول أوروبا الشرقية التي انضوت في «الحلف»، إذا نجح «القيصر» في إخضاع أوكرانيا على مرأى من أمريكا والغرب.
فالسؤال المطروح ليس عمّا إذا كان بوتين سيبقى في أوكرانيا… بل ماذا ستكون خطوته التالية بعد أوكرانيا؟ لا يستسيغ طلب جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويُرسل رسائل تهديد إلى السويد وفنلندا إن تجرأتا على الالتحاق بـ«الناتو». ستزيد شهية الرجل مجدداً في القضم وفي التمدّد لانتزاع مزيدٍ من الأقاليم والمناطق المحيطة بروسيا، لن تكون مولدوفيا ولا كازاخستان بمنأى عنه. وجمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) في عين العاصفة تماماً كما بولندا ورومانيا بفعل انضمامها إلى الأطلسي.
الغرب يهتزُّ مع وصول حرب بوتين إلى قلب أوروبا، لا بل ينتفض على ذاته وعلى «الدب الروسي». من المُبكر الجزم بمآلات الغزو لأوكرانيا ومسار تبدّل الأمور. فحين كان باب التفاوض متاحاً لمنع الانزلاق، انتهجت أوروبا سياسة التردّد في العقوبات الاقتصادية بدل سياسة الردع. اليوم، تجري عمليات التحشيد الدولي على ضفتي الصراع. وباتت الحرب تدقّ مباشرة أبواب دول الحلف الأطلسي، فأي خطأ في الحسابات سيجرّها إلى حرب شاملة، هي التي يتم وصفها بـ«الحرب العالمية الثالثة».
القدس العربي
—————————
هل بلغت العقوبات الأوروبية ضد روسيا أقصى الممكن؟/ آدم جابر
يدخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه العاشر، وسط تكثيف للعقوبات الأوروبية على موسكو، وتنديد أوكراني برفض حلف الأطلسي لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا.
«الحرب التي أشعلها سيد الكرملين فلاديمير بوتين، لم تترك أي مجال للتباين في وجهات النظر بين الدول الأوروبية» يقول الدكتور محمد كلش الصحافي والمحلل السياسي المقيم في باريس. ففي مواجهة الغزو الروسي المستمر، واصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فرض العقوبات على روسيا، حيث أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير أن «روسيا ستواجه حربا اقتصادية وأن الغرب سيدفع اقتصادها إلى الانهيار».
فبعد إعلانه الأسبوع الماضي عن حزمة من العقوبات تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة بما في ذلك شركات في مجال الدفاع، والتي سبقها إعلان ألمانيا عن تجميدها خط أنابيب الغاز الحيوي والمثير للجدل «نورد ستريم 2» لنقل الغاز والذي كان من شأنه أن يزيد من شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا، خطى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع خطوة أخرى أكثر تشددا تجاه موسكو باستبعاده سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للمرسلات الذي يدعم المعاملات العالمية، وهو مطلب كانت تلح عليه الحكومة الأوكرانية لما له من آثار اقتصادية محتملة على موسكو.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يُدرج بنكي «سبير بنك» أكبر بنك في روسيا، ولا «غازبروم بنك» ضمن قائمته هذه، كونهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، اللذين ما تزال الدول الأوروبية تشتريهما على الرغم من حزمة العقوبات المشددة التي فرضتها هذه الدول على موسكو. فبرلين وروما قد حذرتا في الأيام الأخيرة من أنهما لن تتمكنا من تسديد ثمن إمداداتها من الغاز الروسي في حال تم منع وصول البنوك الروسية المسؤولة عن هذه المعاملات إلى نظام «سويفت».
الغاز.. يد أوروبا التي تؤلمها
رغم القرار الألماني بتجميد العمل بخط «نورد ستريم 2» إلا أن استهداف قطاع الطاقة الروسي ليس بالأمر السهل بالنسبة إلى الدول الغربية، لا سيما الدول الأوروبية، في مقدمتها ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير جداً على الغاز الروسي، إذ تستورد نحو 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا التي تعد المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا (41 في المئة).
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال إن بلاده مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا، تزامناً مع تخصيصها مبلغاً استثنائياً بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت بهدف ضمان إمداداتها. الوزير، أقرّ بأن برلين تتوقع « تداعيات كبيرة» على اقتصادها من جراء العقوبات التي فرضها الغربيون على روسيا، موضحاً أن «لدى الشركات الألمانية نحو عشرين مليار يورو من الاستثمارات في روسيا» علما أن «شركات التأمين لا تغطي منها سوى 7.4 مليارات يورو».
وفي عريضة نشرها في صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السابق برنار أكوير إنه «إذا كان هناك مجال واحد سيكون للحرب في أوكرانيا تأثير عميق عليه، فهو سوق الغاز العالمي، لا سيما بالنسبة لأوروبا. ولذلك، فإن الحرب اليوم تجعل الغاز وسيلة ضغط رئيسية وسلاحًا اقتصاديًا هائلاً في أيدي روسيا يعرض الأوروبيين لعواقب وخيمة ودائمة. في مواجهة هذه الصدمة الغازية، وهي أكثر خطورة من الصدمة النفطية الأولى في السبعينيات، يجب على أوروبا أن تجمع نفسها وتراجع سياستها في مجال الطاقة دون تأخير».
جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، شدد على أن الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر أن «المهمة الوجودية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هي تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي والتحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين» موضحا في الوقت نفسه أن «تحول أوروبا، التي تستورد حوالي 40 في المئة من حاجاتها من الغاز من روسيا، لن يكون سهلا».
الإعلام الروسي:
«حدود الحرية تنتهي هنا»
العقوبات الأوروبية طالت أيضا الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين الحكوميتين «آر تي» و«سبوتنيك» معتبراً أنهما أدوات «تضليل» من جانب موسكو في حربها ضد أوكرانيا. وبالتالي، لم يعد بالإمكان، بموجب هذا القرار الأوروبي، بث محتوى من «سبوتنيك» و«آر تي» باللغات الانكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية على شبكات التلفزة والإنترنت. ومساء الجمعة، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض «حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد روسيا، في حال لم يوقف رئيسها فلاديمير بوتين الحرب التي بدأها على أوكرانيا» فون دير لايين، أوضحت قائلة: «نحن حازمون، نحن مصممون، نحن متّحدون». غير أن «مسألة الطاقة تؤكد أن على الخلاف الحاصل على الرغم من الصورة الأولوية عن الانسجام الأوروبي- والأوروبي والأوروبي-الأمريكي في مواجهة روسيا» كما يوضح الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية.
وفي خطوة أثارت حفيظة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفضت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بما في ذلك الدول الأوروبية الكبرى، هذا الجمعة طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، مكتفين بتحذير الروس من عقوبات جديدة. الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، برر هذا الرفض بالقول إن «الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية.. إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها الكثير من الدول وتتسبب بأزمة إنسانية كبيرة». الرئيس الأوكراني، عبر عن أسفه لما وصفه بـ«القرار المتعمّد» من حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن الحلف أعطى بهذا الرفض لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية «برفضها فرض منطقة حظر جوي».
وسط ذلك، عاد ملف الهجرة واللجوء من جديد ليلقي بظلاله على دول الاتحاد الأوروبي مع فرار عشرات الآلاف من الأوكرانيين من بلدهم على وقع القصف الروسي. ومع بروز أزمة هؤلاء اللاجئين الأوكرانيين، قرر الاتحاد الأوروبي تفعيل توجيه يعود إلى عام 2001 يمنح «حماية مؤقتة» للأشخاص الفارين من الحرب بأوكرانيا. وهي سياسة تتناقض مع التحفظ والتردد الذي تم التعبير عنه خلال أفغانستان وسوريا.
أبواب العلاقات موصدة
ونوافذ الحوار مواربة
على الرغم من حزمة العقوبات الأوروبية المعلن عنها ضد روسيا وتهديدها بعقوبات إضافية قاسية، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبقى باب الحوار مفتوحاً مع نظيره الروسي، حيث أكد في خطاب متلفز ليلة الأربعاء، عزمه على «البقاء على اتصال» مع فلاديمير بوتين، قائلا: «اخترت البقاء على اتصال، قدر ما الامكان وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى اقناعه بالتخلي عن السلاح ولتجنب انتشار واتساع نطاق الصراع قدر الامكان».
بعد ذلك بساعات، أجرى ماكرون مكالمة هاتفية مع بوتين، بطلب من الأخير، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. الرئيس الروسي أخبر نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور «وفقا للمخطط» الذي وضعته موسكو وأنها «ستتفاقم» إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، وفق قصر الإليزيه، الذي أوضح في الوقت نفسه أن ماكرون يعتقد أن «الأسوأ لم يأت بعد» في أوكرانيا، بعد هذا الاتصال الهاتفي. وكشف مسؤول فرنسي أن الرئيس ماكرون أبلغ بوتين أنه ارتكب «خطأ فادحا» في حق أوكرانيا وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف وأن الحرب ستكلف روسيا غاليا على المدى الطويل.
غداة ذلك، المستشار الألماني أولاف شولتس، حاول هو الآخر الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً مع موسكو، حيث أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، بمبادرة من الأول. مكالمة، أكد بوتين خلالها أن «القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية» معتبرا أن الاتهامات بهذا الخصوص مفبركة، وأن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول «بكل المطالب الروسية» وفق ما أفاد الكرملين.
علاوة على هذه العقوبات الأوروبية في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، يبدو أن «أوروبا أخذت تتشكل جيوسياسياً واستراتيجياً، كما هو الحال مع ألمانيا التي بدأت تغير من عقليتها وتخصيصها 100 مليار يورو لقواتها المسلحة في تحول غير مسبوق» كما يقول الدكتور خطار أبو دياب، معتبراً أن «أخطر ما في التطورات أن الحرب عادت إلى أوروبا وذكريات الثلاثينات عادت لتلقي بظلالها على القارة». الرئيس الفرنسي تحدث على هذا المنوال في خطابه هذا الأسبوع عن أوكرانيا، مشدداً على أنه: «أمام هذه العودة الوحشية للأحداث المأساوية في التاريخ، يجب أن نرد بقرارات تاريخية.. لقد دخلت أوروبا حقبة جديدة». واعتبر ماكرون أن القمة الأوروبية غير الرسمية التي ستعقد يومي 10 و11 من الشهر الجاري في قصر فرساي التاريخي، الذي استقبل فيه الرئيس الفرنسي نظيره الروسي في نهاية شهر مايو/أيار عام 2017 «يتعين عليها اتخاذ قرار بخصوص استراتيجية استقلال أوروبا في مجال الطاقة ومسألة الدفاع الأوروبي المشترك».
القدس العربي
————————–
كيف ردت موسكو على عقوبات الغرب؟/ فالح الحمراني
تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على روسيا، تضمنت، حظر استيراد أي شيء من الجمهوريات إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك تصدير عدد من السلع والتقنيات للمنطقة. كما ينطبق الحظر على السياحة والتجارة والاستثمار في بعض قطاعات الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الإجراءات تقييد وصول روسيا إلى سوق رأس المال والسوق المالية للاتحاد الأوروبي. ووافق الرئيس فلاديمير بوتين على تدابير اقتصادية خاصة رداً على عقوبات الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا الاتحادية، ووقع على مرسوم بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالرد على العقوبات، والوثيقة منشورة على موقع الكرملين.
وفرض مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، السبت 26 شباط/فبراير، قيودا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في إطار الجولة الثانية من العقوبات. تحت القيود أيضا كان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف. وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السكرتير الصحافي لرئيس الدولة دميتري بيسكوف ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو ووزير البناء إيريك فايزولين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العقوبات اسم رئيس المجلس العام لحزب روسيا المتحدة الموالي للرئيس بوتين أندريه تورتشاك، ورئيس شركة «نفط روسيا» إيجور تسيتشين، ورئيس شركة «ترانس نفط» نيكولاي توكاريف، ورجال الأعمال الروس الذين يعتبرهم الغرب من المقربين من الكرملين: أليشر عثمانوف، وميخائيل فريدمان، وبيتر أفين، وأليكسي موردشوف، وكذلك عازف التشيلو سيرجي رولدوجين، علاوة على صاحب شركة «فاغنر» الأمنية الخاصة يفجيني بريغوجين وأبنائه.
وشملت العقوبات الاقتصادية مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي بما في ذلك الفعلي والمالي والمصرفي. وأعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت أكبر عقوبات تجارية على الإطلاق تهدف إلى حرمان القطاعات الصناعية الروسية مثل صناعة الدفاع وتصنيع الطائرات وبناء السفن من العناصر التكنولوجية الهامة. في الوقت نفسه، أثرت القيود القطاعية المالية والتكنولوجية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 64 هيكلاً رئيسياً لروسيا، بما في ذلك الإدارة الرئاسية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات الخارجية والشركات العاملة في الصناعات العسكرية والطاقة وتصنيع الطائرات والقطاعات المالية.
وفي قطاع الاقتصاد الفعلي فقد فُرضت عقوبات على شركات المجمع الصناعي العسكري مثل «اوبورن بروم» وشركة تصدير الأسلحة الروسية «روس أبرون أكسبورت» والشركات الصناعية الكبرى لإنتاج الطائرات الحربية «سوخوي» و «توبليف» والمركز الصناعي ـ الفضائي «بروجريس» ومنظمات «كلاشينكوف» و «روس تيخ» و«الماز ـ آنتي» والمصنع المختص بإنتاج عربات القطارات «ارلفاجون زافود» والسكك الحديدية الروسية وصناعة الشاحنات» كاماز» و«سوف كوم فلوت» و«سيف ماش» و«روتيخ ـ آزيموت» بالإضافة إلى الشركة المتحدة لبناء السفن وغيرها. في المجموع، تتكون القائمة من 113 كيانا روسيا.
كما حظر الاتحاد الأوروبي توريد منتجات عالية التقنية إلى روسيا، ولا سيما أنظمة الاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات ومكونات الطيران والفضاء. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على التأمين وصيانة البضائع المتعلقة بهذه الصناعات، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي بيع طائرات جديدة لروسيا ونحن نتحدث عن طائرات ايرباص.
وللرد على العقوبات الغربية في مجال الأعمال تدرس الحكومة، جنبا إلى جنب مع بنك روسيا اتخاذ تدابير إضافية لدعم الأعمال التجارية المحلية. صرح بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في الأول من اذار/مارس الجاري في اجتماع لمقر العمليات لزيادة استدامة تنمية الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات. وتم تشكيل مجموعتين من الإجراءات للمؤسسات الأساسية: تقديم المساعدة الموجهة لمن يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب العقوبات، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تدرس الحكومة مع بنك روسيا، تدابير دعم إضافية تجمع بين الإعانات والتمويل للبنوك التي تعمل مع هذا القطاع من الاقتصاد. وسيجري الحفاظ على الحصص الحالية للمشتريات العامة دون إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعن آفاق الاستثمارات قال ميخائيل ميشوستين إن أفضل الظروف ستخلق للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشاريع داخل روسيا، وستواصل الحكومة إزالة الحواجز الإدارية وإنشاء آليات لدعم المشاريع الجارية بالفعل.
وعلى حد تقديرات إيجور متفييف خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، القريب من الكرملين «من الواضح أن الأزمة الأوكرانية الحالية ستشكل تحديات اقتصادية كلية أكثر خطورة على روسيا مما كانت عليه بعد انضمام شبه جزيرة القرم في عام 2014 نظرا لوضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الرئيسي لموسكو». وبلغت قيمة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، بحسب إحصائيات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في نهاية عام 2020 ما قيمته 192.4 مليار دولار أي 38.5 في المئة من حجم التبادل التجاري للاتحاد الروسي، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي 282 مليار دولار.
وما يتعلق بالعملات فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على الروس على الودائع في البنوك الأوروبية تزيد كميتها على 100 ألف يورو في البنك الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يحظر بيع وشراء الأدوات المالية المقومة باليورو لصالح العملاء الروس. وقررت المملكة المتحدة أيضا منع الروس من الاحتفاظ بودائع في البنوك البريطانية، تزيد عن 50.000 جنيه إسترليني. وردت روسيا وفقا لمرسوم رئيس الاتحاد الروسي على تلك الإجراءات، بانه سيطلب من المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي الخارج اعتبارا من 1 اذار/مارس 2022 تحويل 80 في المئة من العملات الأجنبية إلى العملة الروسية، وغيرها من القيود.
——————————–
الاجتياح الروسي لأوكرانيا الحسابات والتوقعات/ صادق الطائي
أطلقت روسيا فجر 24 شباط/فبراير الماضي عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقبل أن ينتهي الأسبوع الثاني من عمليات الاجتياح العسكري ابتدأت وسائل الإعلام الغربية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومراكز الدراسات الأوروبية طرح قرائتها للموقف، ورسم استراتيجيات للوضع على الأرض، وطرح توقعاتها حول ميزان القوة بين موسكو وكييف، والسعي للخروج بآراء حول مدى إمكانية جلوس الطرفين للتفاوض.
بالطبع الكل يعرف أن هناك فارق قوة كبيرا بين دولة كبيرة بحجم روسيا وبين دولة صغيرة مثل أوكرانيا، لكن المعلقين الغربيين يحاولون التركيز في طروحاتهم على ترسيخ صورة تورط الروس في المستنقع الأوكراني. بينما الجهات الروسية من جانبها ما تزال مصرة على تسويق صورة مفادها أن القوات العسكرية الروسية التي دخلت إلى أوكرانيا مهمتها محددة في مساندة الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا بعد أن تعرضوا للاضطهاد على يد حكومة كييف التي يصفها الإعلام الروسي الرسمي بأنها حكومة يسيطر عليها «النازيون الأوكرانيون».
مقارنة عسكرية
عند المقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني فإن الكفة تميل وبوضوح لصالح الجيش الروسي وبفارق كبير، وبحسب الدراسات المعلنة حول الأمر يبلغ تعداد القوات المسلحة الروسية حوالي مليون جندي ومليونين في الاحتياط، بينما يبلغ تعداد الجيش الأوكراني 200 ألف عسكري وحوالي 900 ألف في الاحتياط، وتبلغ حجم القوات الروسية المهاجمة حوالي 280 ألف جندي.
أما على مستوى المعدات والتسليح فإن الجيش الروسي يمتلك حوالي 2840 دبابة، أي ثلاثة أضعاف تلك التي تملكها أوكرانيا. ويمكن للجيش الأوكراني التخفيف من تأثير الفارق الكبير في سلاح المدرعات بالاعتماد على الأسلحة المضادة للدروع التي جهزه بها الغرب مثل الصواريخ المضادة للدبابات الأمريكية. وبحسب رسم بياني نشره موقع «تي أونلاين» الألماني تمتلك روسيا 570 بارجة وسفينة حربية بما في ذلك 49 غواصة، بينما تمتلك أوكرانيا 24 سفينة حربية فقط وليست لديها غواصات، كما ذكر نفس الموقع أن روسيا تمتلك 1379 طائرة مقاتلة بينما تمتلك أوكرانيا 125 طائرة فقط، وتمتلك روسيا 6255 رأسا نوويا، بينما لا تمتلك أوكرانيا رؤوسا نووية، وحسب وكالة الأنباء الألمانية بلغت الميزانية العسكرية لكييف 4.3 مليار دولار، وارتفعت الآن إلى نحو 5.9 مليار دولار، وهذا يمثل نحو عُشر الميزانية العسكرية الروسية التي تبلغ 61.7 مليار دولار.
أخبار خسائر الحرب قبل نهاية الأسبوع الثاني من العمليات العسكرية بدورها كانت متضاربة بين المصادر الروسية والمصادر الغربية، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء 2 آذار/مارس الجاري، خسائر الجيش الروسي، فذكرت مقتل 498 وإصابة 1597 من العسكريين الروس أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا. كما أكد بيان الوزارة أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني تتجاوز 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.
بينما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية من جانبها إن أكثر من 5840 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء الحرب مخالفة بذلك تصريح سابق للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي يبدو أنه بالغ كثيرا في حجم الخسائر الروسية إذ ذكر إن نحو 9 آلاف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب في بلاده.
كما ذكرت الأخبار الروسية مقتل الجنرال أندريه سوخوفيتسكي القائد العام للفرقة السابعة الروسية المحمولة جواً ونائب قائد الفيلق 41 للأسلحة المشتركة، وكان الجنرال سوخوفيتسكي (47 عامًا) قد ارتقى بشكل سريع سلم الرتب العسكرية، وتولى سلسلة من المناصب القيادية في الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ويعد سوخوفيتسكي أكبر ضابط روسي قتل في العملية العسكرية حتى الآن، وقد نعته جهات روسية رسمية.
أما على صعيد تدمير المعدات فلم يتسن التأكيد من مصداقية الأرقام التي ذكرها طرفا النزاع من جهات محايدة، إذ أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الجيش دمر 29 طائرة روسية و29 مروحية و198 دبابة و846 عربة قتال مصفحة و77 نظاما مدفعيا و305 مركبات. بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1612 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 39 منظومة مضادة للجو من طرز «إس-300» و«بوك إم-1» و«أوسا» إلى جانب 52 محطة رادار. كما تم تدمير 49 طائرة أوكرانية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو، إضافة إلى 606 دبابات، وآليات مدرعة أخرى، و67 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و53 طائرة مسيرة.
ورجّحت دراسة حديثة أصدرها مركز الانتعاش الاقتصادي في لندن بالتعاون مع شركة سيفيتا للاستشارات الإدارية في إستونيا ومركز إيزي بيزنس للأبحاث في كييف وتم نشرها يوم 3 آذار/مارس الجاري أن الكلفة المتوقعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستكون بحدود 20- 25 مليار دولار. وأضافت الدراسة أن الخسائر المباشرة في الأيام الأربعة الأولى من الاجتياح العسكري بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك كلف المعدات العسكرية والخسائر في صفوف الأفراد.
خطر الحرب النووية
تناقلت عدة وسائل إعلام غربية فجر يوم الجمعة 4 آذار/مارس بكثير من الهلع أخبار إصابة محطة زاباروجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب شرقي أوكرانيا بضربات عسكرية، وأن هناك تهديدا بتسرب إشعاعي أعاد للأذهان كارثة تشيرنوبل، وبالرغم من إعلان السلطات الأوكرانية المبكر أنها تمكنت من إخماد الحريق في المحطة، وأن سلامتها النووية باتت مضمونة، إلا إن الرئيس زيلينسكي اتهم روسيا باللجوء للرعب النووي، والسعي لتكرار كارثة مفاعل تشيرنوبل.
الرد الروسي على حادث استهداف المحطة النووية جاء مختلفا، إذ نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن منشأة زاباروجيا النووية تحت سيطرتها وتعمل بشكل طبيعي. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الحرس الوطني الروسي تصدت لمجموعة تخريبية في منطقة مفاعل زاباروجيا، كما حمّلت أوكرانيا مسؤولية الحريق الذي نشب قرب المحطة النووية.
وأعلنت الحكومة الروسية أن الهدف من الاستفزاز في منشأة نووية هو محاولة إتهام روسيا بأنها تعمل على خلق بؤرة تلوث نووي. وحسب ما ذكرته المصادر الرسمية الروسية فإن قوات الحرس الوطني الأوكراني غادرت محطة زاباروجيا قبل وصول القوات الروسية. وأوضح بيان روسي رسمي أن قوات الدفاع الروسية تسيطر على منشأة زاباروجيا منذ 28 شباط/فبراير الماضي.
بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من جانبه، إن دعوات الحلف للسلام لا تعني تخليه عن رفع مستواه الدفاعي وتأمين حدود الدول الأعضاء في الحلف، مطالبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته فورا والبدء في عملية دبلوماسية، قائلا: «نحن لا نسعى إلى الحرب». وبيّن ستولتنبرغ أن الناتو ليس جزءا من الحرب، وسيبقى دوره دفاعيا وسيدعم أوكرانيا ولا يسعى للصدام مع روسيا، مشيرا إلى أن أعضاء الحلف ينسقون ردهم على العدوان الروسي على أوكرانيا وتداعياته طويلة المدى. واعتبر أن الهجمات ضد المنشآت النووية تظهر خطورة الحرب وأهمية سحب روسيا لقواتها والعودة للسلام، مضيفا أن «روسيا دمرت السلام في أوروبا وبدأت حربا لم نرها منذ الحرب العالمية الثانية لخلق واقع جديد».
أحوال المدنيين الأوكرانيين الفارين من مناطق النزاع تزداد سوءا ما دفع موسكو وكييف للجلوس لطاولة التفاوض يوم 4 آذار/مارس للاتفاق على بعض النقاط المهمة، وهذه هي جولة المفاوضات الثانية بين طرفي النزاع، وقد تم فيها مناقشة فتح ممرات إنسانية في بعض المناطق الأكثر تضرراً من العملية العسكرية، مع وقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت. وأشارت تصريحات متطابقة لأعضاء الوفدين الروسي والأوكراني إلى أن الطرفين ناقشا عدد الممرات وآليات عملها. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي: إن «وزارتي الدفاع في روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الآلية» موضّحاً أن الجانبين «ناقشا خلال الجولة بالتفصيل المجموعات الثلاث من الأسئلة التي طرحتها موسكو» في إشارة إلى مطالب نزع السلاح، وحياد أوكرانيا، والاعتراف بسيادة القرم.
وتقول مصادر مطلعة في الأمم المتحدة إن أكثر من 660 ألف مدني فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، إذ يعبر اللاجئون الحدود إلى الدول المجاورة غرب أوكرانيا مثل بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، ومولدوفا. وأبلغ اللاجئون أنهم لا يحتاجون إلى وثائق لدخول البلدان المجاورة، لكن يفضل أن يكون لديهم جوازات سفر أوكرانية أو أجنبية وشهادات ميلاد الأطفال المسافرين معهم ووثائق طبية. ويقدر الاتحاد الأوروبي أن نحو أربعة ملايين شخص قد يحاولون مغادرة البلاد بسبب الغزو الروسي. وقد خفف الاتحاد الأوروبي قواعده بشأن اللاجئين، وأشار إلى إن الدول الأعضاء فيه ترحب باللاجئين «بأذرع مفتوحة».
هدف العمليات والسعي لتحقيقه
ذكرت قناة «CNN» الامريكية يوم 4 آذار/مارس الجاري، نقلا عن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن «القوات الروسية لا تزال على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف وفق تقديراتنا. وما زلنا نعتقد أن نية القوات الروسية هي تطويق كييف واحتلالها في نهاية المطاف» وأضاف «أن القوات الروسية أصيبت بالارتباك وأصبحت بطيئة الحركة بسبب المقاومة الأوكرانية الشديدة».
وردا على تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوكالة «رويترز» الذي طالب فيه المجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي بفرض منطقة حضر طيران في أوكرانيا، إذ قال: «إن فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنى التحتية النووية» وأضاف قائلا: «عشنا ليلة كادت توقف تاريخ أوروبا وأوكرانيا» مشيرا إلى أن استهداف روسيا للمحطة النووية كان مقصودا وهو «إرهاب منظم» حسب وصفه، وقد رد جون كيربي المتحدث باسم وزراة الدفاع الأمريكية على تصريحات الرئيس زيلينسكي بالقول: «لا يمكن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا من دون أن تكون قواتنا الجوية في مواجهة مع الروس». فهل يعني ذلك أن الغرب سيترك كييف تواجه قدرها منفردة؟ هذا ما ستظهره الأيام الآتية.
—————————
اختبار ميونخ.. هل ذاكَر الغربيون دروسهم؟/ عبدالناصر العايد
عندما كنت أرتاد، قبل سنوات، مدرسة Sciences po أو معهد الدراسات السياسية في باريس، كان مدرّس مادة الحرب المعاصرة، وهو ضابط فرنسي متقاعد، يتطرق إلى “درس ميونخ” باعتباره بداهة لا تحتاج إلى إثبات. فالرضوخ واسترضاء ديكتاتور عدواني وتوسعي، لتجنب حرب كارثية يهدد بها، سيؤديان حتماً لمواجهة الحرب لاحقاً. لكن تعاظم خطر المستبد وهوسه السلطوي، قد يبلغ حداً بحيث أن مساراً مثل هذا قد لا يمكن إيقافه سوى باستخدام أقصى درجات العنف المسجل عبر التاريخ.
يقول درس ميونخ، إن ألمانيا التي خرجت من الحرب العالمية الأولى مدمًرة، ومكبلة باتفاقية فرساي 1919، استعادت عافيتها بعد عقدين من الزمن على يد هتلر، الذي راح يستعد عسكرياً لاستعادة مكانة ألمانيا السياسية في العالم أيضاً، وبدأ ذلك من المطالبة بضم مناطق أوروبية لدولته بذريعة أن سكانها يتحدثون اللغة الألمانية. وتحت التهديد بالحرب واستخدام القوة، اجتمع به رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين، ورئيس وزراء فرنسا دلادييه، وهما زعيما الدولتين الغربيتين العظميين حينها، ومنحاه على سبيل الترضية إقليم السوديت في تشيكوسلوفاكيا، إحدى المناطق التي كان يطالب بها، لأنها كانت جزءاً من الإمبراطورية المجرية النمساوية التي يعتقد هتلر أنها أحد أسلاف ألمانيا المعاصرة. وهكذا، وقّعا معه مع عرف بمعاهدة ميونخ العام 1938، بعدما وعدهما الزعيم النازي بأن يكف عن المطالبة بمزيد من الأراضي. ردود الأفعال على الاتفاقية كانت عنيفة. سمّتها تشيكوسلوفاكيا، التي كانت مرتبطة بحلف عسكري مع فرنسا، “خيانة ميونخ”.
إلا أن الدرس البليغ الذي ما زال التاريخ السياسي الغربي يحفظه، جاء من الزعيم البريطاني المخضرم تشرشل، الذي كان في المعارضة، ووبخ رئيس وزراء بلاده الذي رفع وثيقة المعاهدة قائلاً “ها قد حققنا السلام في زماننا”، فقال له في مجلس العموم بأنه أحمق، وفاشل، وقد ارتكب خطأ لا يغتفر. فهتلر سيطالب الآن بمزيد من الأراضي، وسيشن حرباً عالمية ثانية في عموم أوروبا، وأن فرنسا وبريطانيا ستدفعان غالياً ثمن هذه الغلطة الشنيعة. وهو ما حدث بالفعل، إذ نقض هتلر الاتفاقية بعد ستة أشهر فقط، واجتاح ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا، ثم بولندا، ثم دول أوروبا، واحدة بعد الأخرى، بما فيها فرنسا، ولم ينقذ بريطانيا حينها سوى عودة تشرشل إلى القيادة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن بعد تدمير القارة الأوروبية تقريباً.
معهد الدراسات السياسية في باريس الذي يحتفي بهذا الدرس، هو نفسه الذي تخرجت فيه نخبة الساسة الفرنسيين اليوم، وعلى رأسهم ايمانويل ماكرون. لكنه ليس الوحيد الذي يعتمده، بل تعتمده كافة الجامعات والأكاديميات العسكرية الغربية، مثل ويست بوينت الأميركية الشهيرة، وجرى استخدامه مراراً في الحرب الباردة، كما ذكره جورج بوش الأب حرفياً عند تبريره لشن الحرب على العراق بعد غزوها الكويت العام 1990.
هل ينطبق مثال ميونخ على حالة بوتين في أوكرانيا اليوم؟ يمكن للمرء تتبع الملخص أعلاه واستبدال اسم هتلر ببوتين، وروسيا بألمانيا، والامبراطورية المجرية النمساوية بالاتحاد السوفياتي، والسوديتت بشبه جزيرة القرم، ليكتشف أن درس ميونخ مرّ مرور الكرام، منذ أن تغاضى الغرب عن استيلاء بوتين على جزيرة القرم العام 2014.
البيئة الاستراتيجية أيضاً تكاد تكون مشابهة، خصوصاً نوع الشخصيات التي تحكم القوى الغربية العظمى. فسواء تعلق الأمر بباراك أوباما أو جو بايدن، فإنهما ليسا بمبعدة على الإطلاق من سلفَيهما الغربيين اللذين وقعا اتفاق ميونخ. لا ينقص المشهد سوى قائد لديه بُعد النظر الاستراتيجي، مثل تشرشل، يستطيع أن يأخذ دفة القيادة ويقول: يجب أن يحسم هذا الأمر الآن، وفي أوكرانيا، وإلا فإن الزمن لن يطول قبل أن تنهمر القنابل والصواريخ، بما فيها النووية، على أوروبا كلها والعالم بأسره.
قد يظهر من يعترض هنا قائلاً أن موقفاً مثل هذا، سيدفع بوتين للجوء إلى السلاح النووي وتدمير الكوكب. أصحاب هذا الرأي على حق، فيما لو كان الزر النووي الروسي مثل قابس المصباح في غرفة نوم بوتين، يمكنه أن يضغط عليه ثم يخلد إلى النوم. لكن الأمر في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. والردع الغربي، بشقيه التقليدي والنووي، تتراكم تفاصيله وأدواته منذ أكثر من نصف قرن لمنع حدوث ذلك. وحتى لو وصلت إصبع بوتين إلى مقابس بعض الأسلحة النووية، ومع أنها قد لا تتجاوز الأراضي الروسيّة، فإنه سيخسر ما تبقى من ترسانته النووية في دقائق، وستنفجر في أراضي روسيا ذاتها، لتصبح تلك البلاد أثراً بعد عين.
هو سيناريو مرعب بلا شك، لكنه بعيد الاحتمال نوعاً ما. وما قد يحدث هو أن يستخدم بوتين السلاح النووي في نطاقات تكتيكية محدودة في أوكرانيا، وفي إطار المعركة التقليدية، كما تقتضي العقيدة الروسية المعاصرة، وذلك ليظهر جديته وعزمه. لكن، إذا أظهر العالم الغربي جديته بدوره، وردّ على سلوك مثل هذا على نحو موحد وحازم، وأجبر هذا المهووس النووي على الاستسلام، فإن العالم سينجو إلى زمن غير معلوم من تهديد أخطر بكثير.
المدن
——————–
بينيت التقى بوتين بعِلم واشنطن:مقامرة اسرائيلية خطرة
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح الأحد، اتصالاً هو الثالث خلال 24 ساعة، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من زيارة سرية قام بها بينيت إلى روسيا.
وكشف الصحافي الإسرائيلي بارك رافيد بعضاً من كواليس زيارة بينيت إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن بينيت تحدث مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان وأبلغه أنه ذاهب إلى موسكو للقاء بوتين، لكنه لم يطلب موافقة الولايات المتحدة.
وأشار في سلسلة تغريدات، إلى أن بينيت أراد إشعار البيت الأبيض بذلك، رغم عدم حماس سوليفان للأمر. وأكد أن مسؤولي البيت الأبيض أكدوا لبينيت أنهم متشككون بشأن فرص تأثير زيارة بينيت ولقاء بوتين على الموقف في أوكرانيا.
ووصل بينيت إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة مفاجئة السبت، التقى خلالها بوتين. وشارك بينيت في رحلته وزير الإسكان زئيف إلكين، ومستشار الأمن القومي أيال حولتا.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن بينيت اجتمع مع الرئيس الروسي في الكرملين السبت، لبحث أزمة أوكرانيا.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي الذي استمر ثلاث ساعات”، واشار البيان إلى أن بينيت “ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا”.
وتابع البيان: “يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم، حيث ناقش رئيس الوزراء أيضاً مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)”.
وقالت مصادر لوكالة “سبوتنيك” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل بالرئيس الأوكراني، بعد انتهاء اجتماعه مع الروسي في الكرملين مساء السبت.
في حين أن إسرائيل، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، أدانت الغزو الروسي وعبرت عن تضامنها مع كييف وأرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وقالت إنها ستحتفظ باتصالاتها بموسكو أملاً في المساعدة في تخفيف حدة الأزمة.
كذلك تدرك إسرائيل حجم الدعم العسكري الذي تقدمه روسيا لرئيس النظام السوري بشار الأسد في سوريا المجاورة، حيث تهاجم إسرائيل من وقت إلى آخر أهدافاً عسكرية لإيران وحزب الله. وتمنع الاتصالات مع موسكو وقوع اشتباكات بطريق الخطأ بين القوات الروسية وإسرائيل.
وأفادت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح الأحد، إلى أن زيارة بينيت إلى موسكو كانت قد تبلورت الأربعاء، في أعقاب المحادثة الهاتفية التي أجراها الأخير مع بوتين، وفي ظل توجهات كل من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا إلى بينيت لدفعه إلى التوسط بين كييف والكرملين.
وفيما أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”(واي نت) أن بينيت حصل على “مباركة” البيت الأبيض قبل سفره إلى موسكو واجتماعه ببوتين، حذّر المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل من أن تقدم إسرائيل على إغضاب واشنطن أو استفزازها في سياق التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف.
وبحسب “واي نت”، فإن بينيت أطلع الوزراء يائير لبيد وبني غانتس وأفيغدور ليبرمان على الرحلة المخطط لها إلى موسكو وبرلين قبل مغادرته إلى موسكو. وبعد الاجتماع المطول مع بوتين في الكرملين، والذي استمر حوالي ثلاث ساعات، غادر بينيت إلى برلين، حيث اجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وشكك مسؤولون أوكرانيون بفرص بينيت في النجاح في جهود الوساطة؛ كما شكك مسؤولون روسيون في ذلك، بحسب ما جاء في تقارير وردت من موسكو الأحد، مشيرين إلى الجهود التي يبذلها بينيت، والمدفوعة برغبته في لعب دور مركزي على الساحة الدولية، تأتي بضغط من الجانب الأوكراني، فيما يصرّ بوتين على مطالبه لإنهاء “العملية العسكرية” في أوكرانيا.
وعلق المتحدث الرئاسي الأوكراني سيرغي نيكيفوروف على تحركات بينيت قائلاً إن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين – إذا وافق الرئيس الروسي على عقد اجتماع ثنائي، وأضاف “لن نتمكن من تقييم نتائج وساطة بينيت حتى نحصل على إشارة واضحة منه أو موافقة بوتين على الاجتماع”.
ووفقا ل”واي نت” فإن المحاور الرئيسية التي ناقشها بينيت مع بوتين هي “الحاجة إلى وقف إطلاق النار”، وطالب بوتين من بينيت، الامتناع عن تزويد كييف بمساعدات عسكرية، كما ناقش الاثنان وضع اليهود والمواطنين الإسرائيليين في مناطق القتال؛ وفي هذا السياق، طلب بينيت من بوتين الموافقة على فتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء آمن للمدنيين، كما طلب منه للسماح لليهود الذين يعيشون في روسيا ب”الهجرة” إلى إسرائيل.
مخاطرة بينيت
واعتبر المحلل العسكري في موقع “واي نت” رون بن يشاي أن بينيت “يخاطر بشكل كبير بلعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا”، مشيرا إلى أنه “إذا نجحت الوساطة وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهذا بلا شك سيعزز مكانته الدولية. أما إذا فشلت المفاوضات فهناك تخوف من تحميل إسرائيل المسؤولية عن فشل المفاوضات مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها”.
وأشار بن يشاي إلى أن بينيت طرح خلال المحادثات مع بوتين، مسألة التنسيق العسكري المشترك في سوريا، وطالب بالحفاظ على حرية العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في محاولة لمنع إيران من التمركز العسكري في سوريا وإمداد حزب الله بالسلاح؛ كما تطرّق اللقاء إلى تطور المحادثات في الملف النووي الإيراني والاقتراب من التوصل إلى اتفاق في العاصمة النمساوية فيينا، إذ جدد بينيت موقف إسرائيل الفرافض للعودة إلى الاتفاق النووي.
كما شكك المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل في فرص نجاح بينيت في لعب دور الوسيط بين موسكو وكييف، وتساءل: “ما الذي يمكن أن تحققه إسرائيل حيث فشلت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؟”، مشيراً إلى أن بوتين يحاول الاستفادة من “توق” بينيت “إلى الظهور على الساحة الدولية”، في حين أن عيون وسائل الإعلام تركز جميعها على موسكو وكييف.
ووصف هرئيل جهود بينيت ب”المقامرة الصعبة التي تعكس نفسية بينيت”، الذي يسعى إلى تحقيق قفزة نوعية على صعيد مكانته الدولية من هذه الفرصة التي يراها مواتية؛ مشيراً إلى مجموعة متنوعة من المصالح الإسرائيلية التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب: الجالية اليهودية من أوكرانيا التي تعرضت للهجوم، ومساعدة اليهود من روسيا الذين قد يرغبون في “الهجرة” إلى إسرائيل، وموقف روسيا في المفاوضات النووية مع إيران ورغبة إسرائيل في الاستمرار في التمتع بحرية هجومية في سوريا.
وشدد هرئيل على الانعكاسات السلبية لمحاولات بينيت إذا لم تكن نتاج تنسيق كامل مع الجانب الأميركي، وقال: “يجب أن ينسق بينيت كل تحركاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن، لأن اعتماد إسرائيل الإستراتيجي والأمني على أميركا اعتماد مطلق، وأهم من أي لفتة أو تنازل يمكن أن تنتزعها تل أبيب من الروس”.
وعن اجتماع بينيت مع المستشار الألماني، اعتبر هرئيل أن ذلك يشكل مؤشراً على “ما يشغل بوتين حتى في خضم الحرب: تجديد مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا، نوردستريم 2، الذي جمده الألمان كعقوبة فورية ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا”، مشيراً إلى أن “أوروبا في حاجة ماسة إلى الغاز الروسي – ويعتمد الاقتصاد الروسي على استمرار صادرات الغاز”.
——————————-
مؤرخ بريطاني: الخطآن اللذان تسببا في حرب أوكرانيا
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية (The Wall Street Journal) مقالا عن آراء المؤرخ المخضرم المختص بتاريخ روسيا روبرت سيرفيس الذي تنبأ في 2021 بحرب روسيا على أوكرانيا يقول فيها إن هناك خطأين تسببا في ذلك، وإن الحرب مأساة لأوكرانيا وروسيا معا، ودعا إلى عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة.
يقول سيرفيس في المقال الذي كتبه تونكو فاراداراجان إن حرب روسيا على أوكرانيا نتجت عن خطأين إستراتيجيين فادحين، جاء الأول في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عندما وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا ميثاق الشراكة الإستراتيجية، والذي أكد دعم أميركا حق كييف في متابعة العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO).
وأوضح أن هذه الاتفاقية جعلت من المحتمل أكثر من أي وقت مضى أن تنضم أوكرانيا في نهاية المطاف إلى الناتو، وهو احتمال لا يطاق بالنسبة لبوتين، ويصف سيرفيس هذه الاتفاقية بأنها “كانت القشة الأخيرة”، إذ بدأت بعدها استعدادات فورية لحرب روسيا على أوكرانيا.
سوء إدارة مخجل
كذلك وصف سيرفيس هذه الاتفاقية بأنها سوء إدارة مخجل من قبل الغرب، الأمر الذي قدم تشجيعا لأوكرانيا في ما يتعلق بمسألة الناتو، ولم يتم تقديم أي شيء للأوكرانيين للاستعداد لرد فعل روسيا.
ويشير سيرفيس إلى أن أوكرانيا واحدة من النقاط الساخنة في “العالم العقلي” لفلاديمير بوتين، وقد عرف الغرب أنه منذ عام 2007 على الأقل عندما ألقى بوتين خطابا في مؤتمر ميونخ حول السياسة الأمنية، إذ كان خطابا غاضبا من فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهي الفكرة التي وصفها بوتين في 2012 بأنها غير قابلة للتفاوض.
وكان سيرفيس قد كتب في يوليو/تموز 2021 مقالا توقع فيه الحرب، ويلخص الأمر بالقول “الأوكرانيون والروس شعب واحد، لقد قال بوتين ذلك مرات عديدة من قبل، لكن ليس بغضب وبقوة وعاطفية مثل الآن”.
بوتين يحتقر الغرب
والخطأ الإستراتيجي الثاني -وفقا لسيرفيس- كان استهانة بوتين بمنافسيه، فهو يحتقر الغرب ويراه منحطا وفوضويا سياسيا وثقافيا، وأن قادته كانوا “من ذوي النوعية الرديئة وعديمي الخبرة مقارنة به”.
ووفقا لتقديرات بوتين، كانت الحرب بمثابة “مهمة سهلة” ليس فقط في ما يتعلق بأوكرانيا ولكن بالغرب أيضا، لقد أمضى 4 سنوات متفوقا على دونالد ترامب، وكان يعتقد أن تقاعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترك الغرب بلا دفة، وأدى ذلك إلى تهيئة المشهد “للمفاجأة التي حصل عليها عندما شن حربا على أوكرانيا، عندما وجد أنه قد وحد الغرب عن غير قصد، وأن ما فعله كان عكس ما أراد”.
ويصف سيرفيس الرئيس الروسي بأنه متهور ومتوسط المستوى، وسخر من فكرة أنه يتمتع بنوع من العبقرية، خاصة أنه قلل من تقدير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى به في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد 6 أشهر من تولي الأخير منصبه، وقال إنه بعد أن قسى بوتين كالمعتاد في مناقشاته على زيلينسكي خرج الأخير وهو “يرتعش” بشكل واضح.
معادٍ للشيوعية
ويقول سيرفيس إن المفتاح لفهم بوتين هو إيمانه الراسخ بأن روسيا “قوة عالمية عظمى”، وأن مجال نفوذها يجب أن يمتد إلى أكبر عدد ممكن من الجمهوريات السوفياتية السابقة، ولا توجد من بين هذه الجمهوريات ما هي أهم من أوكرانيا.
ويصف المؤرخ بوتين بأنه ليس شيوعيا، بل معاديا للشيوعية، ويعتبر أن الفترة السوفياتية بمثابة “قطيعة” مع الطريق إلى العظمة الذي كان ينبغي لروسيا أن تسلكه.
ويؤمن بوتين بـ”روسيا الخالدة” وينظر إلى لينين بـ”سخرية وكراهية” لأنه أوقف التوسع الروسي، فيما قد يقول “أحيانا أشياء ممتعة عن ستالين، ولم يقل أبدا أي شيء إيجابي عن لينين، كما أنه يحتقر الديمقراطية، ويؤمن بحق القيادة في فرض سلطة الدولة على المجتمع، ومن وجهة نظر بوتين هذا مفيد للمواطنين لأنه يجلب الاستقرار والقدرة على التنبؤ في حياتهم، كما يؤمن بأهمية الشرطة السرية كعنصر مساعد للحكومة”.
ومع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا في أسبوعها الثاني لم يخفِ سيرفيس تشاؤمه، ويقول إن الوضع يمضي نحو حرب طويلة الأمد ستنتهي بإخضاع أوكرانيا “بوتين سينتصر في الحرب بعد أن يدمر أوكرانيا وشعبها، لكنه لن يفوز بالسلام، إن مهمة تهدئة الأوكرانيين تتجاوز الروس، هناك الكثير من الغضب الذي تم إطلاقه في أوكرانيا”.
الحل في عزل بوتين
ويقول سيرفيس إنه يجب عزل بوتين من السلطة، هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء عذاب أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم بـ”انقلاب قصر” والذي يبدو في الوقت الحالي “غير محتمل للغاية” لكنه يمكن أن يصبح مقبولا، أو بانتفاضة جماهيرية بمظاهرات الشوارع نتيجة الضائقة الاقتصادية التي فرضتها الحرب والعقوبات الغربية.
ويوضح سيرفيس أنه كلما طالت الحرب زاد احتمال أن ترى روسيا حركات احتجاجية يصعب احتواؤها، خاصة إذا كان لدى الشرطة نفسها عناصر في صفوفها تتعاطف مع الأشخاص الذين يُفترض أن تقوم بقمعهم.
ويختم سيرفيس بأن حرب روسيا على أوكرانيا ليست مأساة لأوكرانيا وحدها، إنها مأساة لروسيا أيضا، والشعب الروسي لا يستحق حاكما مثل بوتين “لم يحالفهم الحظ كثيرا مع حكامهم خلال الـ150 عاما الماضية، في الواقع، لقد كان حظهم مروعا”.
المصدر : وول ستريت جورنال
—————————-

======================
تحديث 07 أذار 2022
—————————
ما بين موسكو وكييف: شيوعيِّون ضلُّوا طريقهم المؤدِّية إلى مناهضة الإمبريالية/ حسان خالد شاتيلا
من المفترض أن الأممية الشيوعية أو وحدة الشعوب معاديةٌ للإمبريالية بجميع وجوهها أيا كانت. لكن أزمة التنظيمات الشيوعية منذ نشأتها في منتصف القرن التاسع عشر واجهت العقبات من جراء مسألة التوفيق، من عدمه، بين المسألة القومية ووحدة البروليتاريا في العالم الرأسمالي. عن ذلك نجم تبعثر هذه التنظيمات، إن لم نعترف بتبعثرها واستفحال التناقضات فيما بينها. من المفترض أيضا أنها معادية، وعلى حد سواء، للحكومات غير الوطنية، ذات النظام الرأسمالي، رأسمالية الدولة وما يسمونه نظام التطور غير الرأسمالي، مما أدى، هنا وهناك، في مصر ، سورية والعراق، على سبيل المثال، إلى التحالف مع هذه الأنظمة تحت شعار: “الإمبريالية تكشر عن أسنانها فلا منص من التحالف مع هذه الأنظمة”. هذا مع العلم أن ما فعله حافظ الأسد، تحت قبة “الجبهة الوطنية التقدمية”، عندما استولى على السلطة كي يحول دون نجدة الجيش السوري للثورة الفلسطينية في إربد، ثم توجيه مدفعيته الثقيلة للمخيمات الفلسطينية في لبنان، ومشاركته في مؤتمر أوسلو، فضلا عن لقائه بالرئيس الأمريكي فورد بحنيف، إلخ، إلخ، ولجوئه إلى أردوغان تركيا الإمبريالية، صديق إسرائيل، لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الأسد ونتيناهو، إنما يُعتبر كل ذلك تنفيذ للسياسة الإمبريالية، أمريكية، أوروبية، بالنيابة عن هذه الأخيرة.
بتعبير آخر، فإن “التعايش السلمي” حلَّ هنا محل الأممية الشيوعية”. هذا وذاك من تناقضات السياسية البورجوازية، بالرغم من استعانة هذه الدول، دولة بشار الأسد عل ىسبيل المثال، بالإمبريالية، مستمر، مستمر، من أجل حفاظ هكذا دول على سلطتها، وكي ما تسيطر على المجتمع الإنساني، لأنها عاجزة بالاعتماد على جيشها وأجهزتها الاستخباراتية الحفاظ على سلطتها البورجوازية وإلحاق الهزيمة بأعدائها المحليين، ومنهم المسلمة والإسلامية. مثال أوكرانيا، سوريا، العراق، وأفغانستان، إلخ، يؤكد أن هذه الحكومات عميلة للنظام الرأسمالي العالمي، ومجرمة بحق شعوبها، منها، ولاسيما ، طبقاتها الشعبية. بتعبير آخر، فإن هذه الدول لا حياة لها ما لم تعتمد على روسيا تارة، أمريكا وأوروبا تارة أخرى. أوكرانيا في جميع هذه الحالات ماثلة في صميم هذه الصراعات التاريخية وتناقضاتها.
من المفترض أن تَنفُضَ الأممية الشيوعية يدها من كل هؤلاء وأولئك لتتبنى استراتيجية إسقاط الأنظمة البورجوازية ما دامت هذه الأنظمة معولمة، والنضال من أجل بناء الاشتراكية ما دامت الوطنية إذا اقترنت بمحاربة الإمبريالية تتطور، تتحول، لتغدو ملازمةً للاشتراكية. من المفترض أيضا أن هذه الاستراتيجية مستمدة من الصراع الطبقي. ذلك أن وحدة الشعوب لا تستقيم، كالصراع الطبقي، ما لم تحفر خندقا واحدا في حربها ضد الإمبريالية والرجعيات الحاكمة، روسية، أمريكية، وغيرها. لكن شيوعيين ما يتناسون أن العدو الأول للشيوعيين في ساحة المعركة ضد العولمة النيوليبرالية هي الأنظمة العاجزة عن ممارسة الحرية، تلك الأنظمة النيوليبرالية المعادية للمجتمع الإنساني والتي تجعل من الإنسان بضاعة. هي نفسها العاجزة أيضا بالاعتماد الذاتي على جيشها و شبيحتها عن إبادة عدوها الإسلامي الرجعي. شأنها شأن الطبقة الحاكمة في أوكرانيا التي تتبرع ببلادها للحلف الأطلسي لخوفها من السوق الروسية، حتى لو أدى بها الأمر إلى الإخلال بالتوازن الدولي، توازن الخوف، أحد أسس السلام العالمي في عهد الحرب الباردة التي ترافق العولمة، باعتبار أن هذه الأخيرة لم تلغ التناقضات الذاتية للنظام الرأسمالي.
في نهاية الأمر، فإن الإيدولوجية الوطنية، وهي رجعية على نحو مماثل لكل الإيديولوجيات مهما اختلفت أسماؤها، قد طغا عداؤها لروسيا على انضمام أوكرانيا الدولة إلى الحلف الأطلسي، حلف الإمبرياليين. هذا الطغيان المعادي لروسيا والمؤيد لأوكرانيا يلقى تفنيدا من هؤلاء الشيوعيين عندما يذهب هؤلاء وأولئك إلى أن القضية القومية وسياسة التبعية للأطلسي واحدة لا تنقسم، لأن روسيا القيصر بوتين تشكِّل تهديدا لأمن أوكرانيا، ناهيكم عن فزع بولندا ورومانيا من التوسع الروسي. هكذا رأي، سواء أكان يستمد مبرراته من الإيديولوجية البوجوازية، أم من أيديولوجية شعبيوية ما، فإنه في هاتين الحالتين بات يسيطر على العالم اليوم بلجوئه إلى السلاح الإيديولوجي المموَّل من البنوك. عالم الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، الذي بيع بوساطة البنوك إلى الرأسمالية، ووُضعت قيادته تحت أمرة كلاب مسعورة تنبري للدفاع عن إيديولوجياتها التي تُنتِج سياسة الرعب، الحروب، العنف، استلاب الوعي، استغلال قوة العمل، وسلخ الإنسان عن مجتمعه تحت راية الدفاع عن حقوق الإنسان. إنها، من أجل إنجاز أهدافها الاستراتيجية هذه تلغي المجتمع الإنساني باسم دفاعها عن حقوق الإنسان. العلاقة بين الحرب والسياسة لحق بها ما لحق بالإنسان في عهد العولمة النيوليبرالية. فالحرب الباردة الثانية أصبحت تضع الحرب مَنفَذا إلى السياسة، فيما كانت الحرب الباردة الأولى تضع السياسة منفذا إلى الحرب. خطاب الإعلام هذا، كنظيره لدى هذه الشرائح من الشيوعيين، إيديولوجي لا يمت بصلة، من الألف إلى الياء، إلى المعرفة العلمية، الموضوعية، المادية، النضالية، والسياسية التاريخية.
حسان خالد شاتيلا
4 آذار/مارس 2022
————————–
أوكرانيا والعتب السوري في التخلي الأميركي/ سميرة المسالمة
يطرح التشابه الكبير في مشاهد الدمار المروّعة التي تحدثها آلة الحرب الروسية في أماكن انتشارها، في سورية وأوكرانيا، تساؤلات عديدة عند سوريين كثيرين، حول عدم تشابه ردود الفعل الأميركية – الأوروبية ضد الآلة نفسها والجيش نفسه، والحكومة تحت إمرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتلي جنوح طموحه في استعادة مكانة الاتحاد السوفييتي التي أفلتت من يد سابقيه، مهرولاً إلى معركة تصحيح التاريخ، بقوة التدمير النووية الهائلة التي يمتلك أزرارها، ويهدّد باستخدامها وإنهاء بريق الحياة على الأرض في حال تعذّر عليه الانتصار. وفي هذه التساؤلات، أو العتب الذي يصل حد التنديد، إن صح القول، ينطلق السوريون من جهة تصديق مواقف الغرب الإعلامية تجاه قضيتهم السورية، والتغرير بهم أنّهم يقفون إلى جانب ثورتهم، ويدعمون مطالبهم في الحرية وإنهاء عهد استبدادي أمني امتد عقوداً، ومن حقهم في إقامة دولتهم السورية تحت مظلة دستور وقوانين تضمن حريتهم ومساواتهم بوصفهم مواطنين، والاعتراف بتعدّد قومياتهم كما كان حال انطلاقة ثورتهم قبل نحو 11عاماً مترافقة بصيحات الحرية في درعا مهد الثورة، وامتدادها إلى كلّ المحافظات السورية منذ أيامها الأولى، ولا تزال، رغم خفوت أصواتها بفعل علوّ ضجيج أصوات السلاح وطيران روسيا القاتل.
ربما يعقد السوريون، من منطلق عاطفي بحت، تلك المقارنات والمفارقات في المواقف والدعم الغربي العسكري للأوكرانيين الذين يتقدّمهم رئيسهم في الدفاع عن استقلالية بلده، وحرية اختيار موقعها الجيوسياسي، بعد أن جرّبت تلك البلاد مآسي موقعها في قلب العالم السوفييتي وما تلاه، وبين الدعم الغربي الخجول لفصائلهم المعارضة المسلحة والمحفوف بالحذر، والخوف من قوى مشتّتة الهوية والهدف، تحارب ضد النظام السوري (الكتلة الصلبة) المعروف والمجرّب أميركياً وأوروبياً وإسرائيلياً، والذي يواجه معارضيه بجيشه وسلاحه وقوات الدول الحليفة له (إيران وروسيا).
وقد تكون لهذا الإحساس بالظلم الذي يعتريهم أسباب كثيرة، منها الاعتماد على أقوال معارضين كانوا يستقصون كلمة هنا وكلمة هناك، عن وقوف الغرب إلى جانب المعارضة، وتدعيم موقفهم في المفاوضات منذ عام 2014 وحتى ما بعد الجولة المقبلة في 21 مارس/ آذار الجاري، ما يجعل أمر النظام السوري وكأنه انتهى، بين تصريح وآخر يصدر عن مسؤول غربي أميركي أو أوروبي، كما هو الحال في الإعلان، أخيرا، على موقع السفارة الأميركية في دمشق “إن بشار الأسد، وعلى مدى 11 عاماً، عذّب وارتكب جرائم ضد السوريين، … وأن الإفلات من العقاب سينتهي هذا الشهر”، ما يفترض معه هذا من توهمات أنّ حكم الأسد الذي وثقت المنظمات الدولية استخدامه الأسلحة الكيميائية شارف على الزوال، وأنّ حقبة جديدة تبدأ مع مطلع العام 12 لثورة السوريين.
يتهم بعض السوريين الغرب بمواقفه الحالية ضد الحرب الروسية ومناصرته أوكرانيا بأنه خان الثورة السورية، وأخلّ بمبادئه في دعم مطالب الديمقراطية، ويتناسون أن هذا الغرب، ومعه إسرائيل، لم يعلن، في أي موقف صريح، أنه ضد التدخل الروسي في سورية، وأنه اكتفى بمطالبتها بتوضيح مسبق للأهداف التي تنوي ضربها، وأن كل الاتفاقيات التي أتاحت لروسيا توسيع حصّتها في التدخل في سورية، واستعادة نفوذ النظام السوري الداعمة له على المناطق الخارجة عن سيطرته، كانت تعقد مع الولايات المتحدة مباشرة أو عبر أصدقائها تركيا مثلاً، من الاتفاقية السرّية (كيري – لافروف) في 9 سبتمبر/ أيلول 2016 إلى مناطق خفض مناطق خفض التصعيد في مايو/ أيار 2017، إلى اتفاق إجلاء مقاتلي الغوطة في مارس/ آذار 2018، واتفاق منطقة حوران (الجنوب السوري) في 2018، إلى الفشل الذريع في عقد أيّ اجتماع تفاوضي حقيقي ومنتج في جنيف وغيرها فوق الطاولة أو تحتها.
عقد المقارنات بشأن الموقف الغربي من الحربين اللتين شنتهما روسيا على السوريين المعارضين وعلى أوكرانيا كبلد واحد، ليست في ميزان حسنات المحللين، على الرغم من تشابه الدمار والنتائج على أوكرانيا وسورية، من همجية القصف وعشوائيته واتباع سياسة الأرض المحروقة كما كانت في حلب والغوطة، وقبلها غروزني، وكلّ موقع استفاق فيه حلم القيصر الروسي. وأنّه إذا جاز للسوريين المقارنة، عليهم أن يذهبوا أبعد من ترصّد أخبار الدعم الغربي، إلى ترصد واقع حال “التخلي الأميركي” عن وعودهم الأوكرانيين في حماية حدودهم بعد تخليهم عن الرؤوس النووية لروسيا، وتشابهه مع واقع الثورة السورية وجولات السفير الأميركي في حماة وشد عضد الثوار، في إيحاء بالدعم الكامل الذي تحوّل إلى ما يقرب من “طرفة” الدعاء للأوكرانيين بالنصر.
هذه الحرب محدودة المكان في مشهدها الجغرافي المصغر، لكنّها في حقيقة انتشار مفاعيلها حرب عالمية، شاء الغرب أن يدخلها، أم بقي واقفاً على رؤوس أصابع قدميه معاقباً من نتائجها، فهي أصابته مباشرة في اقتصاده اليوم، وهي لن تنجيه، في حال استمرارها، من تتابع شظاياها في مجتمعاته وقدرتهم على الصبر على حكوماتهم، كما أنها ربما تكون مدعاةً للتقوقع في محميات قومية تعيد خريطة العالم إلى هيئتها البدائية، وتُعلي من أسوار الفصل العنصري بين البشر، وتُسقط ما أنتجته الحضارة الغربية من امتيازات الحرية العلمية والفكرية والسياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، ما لم تستيقظ أوروبا سريعاً من استسلامها لحلم الاكتفاء بالأمان الاقتصادي السعيد، وتبحث عن أمانها العسكري أيضاً.
الانتصار لجهةٍ ما في حربٍ اشتعلت يبقى موقفاً أخلاقياً عند الشعوب، لكنّ الحرب ضمن دائرة الحكومات هي مصالح بالأرقام، الديمقراطيات منها تحسبها وفقاً لمصالح شعوبها. أما الديكتاتوريات فحساباتها على قدر مطامعها في بقائها على كراسيها، وهي لا تختلف عن حسابات القيصر الباحث عن حلمه، ولا يمكن لأحدٍ معرفة ماهية ذلك الحلم وكيف يمكن تحقيقه على أرض الواقع، لكنه حتما أسوأ من كلّ توقعاتنا. يقول الكاتب الروسي العظيم دوستويفسكي: “غالباً ما يتحدّث الناس عن الوحشية للإنسان، لكنّ ذلك غير عادل ومجحف بحق الوحوش، فلا يمكن لحيوان أن يكون بقسوة الإنسان، بتلك القسوة الماهرة والفنية أيضاً”… ويمكن أن نزيد في القول… النووية أيضاً.
العربي الجديد
——————————
هل ظنت روسيا أن كييف كدمشق؟، الصمت عن بوتين بسوريا جعله يعربد بأوكرانيا/ كريستين هيلبيرغ
لقد فعلها فلاديمير بوتين – فالقوَّات الروسية تهاجم أوكرانيا. يمثِّل الجنود والطائرات المقاتلة الروسية بالنسبة للناس في سوريا جزءًا من حياتهم اليومية منذ سنوات، لأنَّ موسكو تستخدم قوَّاتها لتحافظ على بقاء بشار الأسد في السلطة. وتكشف أساليب بوتين في سوريا عن نهج سياسته الخارجية ووعيه الجيوستراتيجي. لقد ميَّزت في ذلك أربعُ سمات نهج رئيس الكرملين بشكل مبدئي.
أوَّلًا: بوتين يريد كسب الاحترام
يسعى الرئيس الروسي إلى الحديث مع الأقوياء في هذا العالم بشكل متكافئ. فهو يقود إمبراطورية ويريد أن تتم معاملته بما يتناسب مع ذلك. وهذا بالضبط ما حقَّقه في سوريا – بثقل روسيا الدبلوماسي وقوَّتها العسكرية وبالدعاية السياسية.
وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتَّحدة تضع موسكو يدها الوقائية على الأسد منذ أحد عشر عامًا، وقد منعت روسيا ستة عشر قرارًا خاصًا بسوريا بين عامي 2011 و2020. ومن خلال ذلك لا يمكن إحالة جرائم النظام السوري بموجب القانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويُسيء النظام من أجل بقائه في السلطة استخدام مساعدات الأمم المتَّحدة، التي تبلغ قيمتها مليارات وتُمَوِّل ثمانين في المائة منها الولايات المتَّحدة الأمريكية وأوروبا، لأنَّ المساعدات يجب توزيعها بالاتفاق مع دمشق ولذلك فهي لا تصل إلى السوريين الأكثر حاجةً وعوزًا، بل إلى السوريين الأكثر ولاءً للنظام.
وفقط محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المتطرِّفين والتي تعتبر ملاذًا لملايين من معارضي الأسد، ما تزال تتلقى وحدها مساعدات إنسانية مباشرة من الخارج. ووصول هذه المساعدات إلى إدلب عبر الحدود يجب أن يتم تمديده كلّ ستة أشهر من قِبَل مجلس الأمن الدولي، ليستجدي الغرب من بوتين السماح له بتقديم المساعدة الإنسانية. لقد أحرز رئيس الكرملين على المستوى الدبلوماسي في سوريا تقدُّمًا كبيرًا.
وعندما لا يمكن منع القرارات، تُخفِّف روسيا من حدة محتواها. وأفضل مثال على ذلك هو القرار رقم 2254 الصادر في شهر كانون الأوَّل/ديسمبر 2015 – أي وثيقة الأمم المتَّحدة، التي لا تزال تستند إليها جميع الجهات الفاعلة في الأزمة السورية حتى يومنا هذا. لقد جاء هذا القرار نتيجة محادثات مكثَّفة بين موسكو وواشنطن، بادرت في شهر تشرين الأوَّل/أكتوبر 2015 مع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بسوريا بالمبادرة الدبلوماسية الوحيدة الجادة من أجل حلّ النزاع.
وكان كلا البلدين في ذلك الوقت منخرطين عسكريًا في سوريا – الولايات المتَّحدة الأمريكية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2014 من أجل محاربة ما يعرف باسم الدولة الإسلامية (داعش)، وروسيا منذ شهر أيلول/سبتمبر 2015 من أجل إنقاذ الأسد، الذي فقد السيطرة على مناطق واسعة من البلاد. وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره في ذلك الوقت جون كيري يعتبران بعضهما متساويين – وذلك بعد عام ونصف العام فقط من إقدام الرئيس باراك أوباما في شهر آذار/مارس 2014 على التقليل من قيمة روسيا واعتبارها “قوة إقليمية”.
والقرار رقم 2254 يطالب بإنهاء الهجمات على المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وكذلك بالإفراج عن المعتقلين اعتقالًا تعسُّفيًا. لقد حاول طيلة أشهر لافروف وكيري التخفيف من حدة التصعيد – ولكن من دون نجاح. وذلك لأنَّ القرار رقم 2254 يحتوي وبتحريض من موسكو على ثغرة – وهي ثغرة “الحرب على الإرهاب”.
إذ إنَّ نصّ هذا القرار يسمح وبصيغة واضحة بمواصلة الهجمات على المجموعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وكذلك “الجماعات المتحالفة معها”. وهذا هو التصريح المطلق، الذي يحتاجه نظام الأسد من أجل الاستمرار في حصاره وقصفه جميع مناطق المعارضة والاستمرار بالتالي في حربه ضدَّ المدنيين.
وروسيا لم تصبح فقط الشريك الحاسم في هذه الحملة، بل باتت تغيِّر قواعد لعبة هذه الحرب. واعتبارًا من صيف عام 2015، أرسل بوتين بناءً على طلب من الأسد قوَّات ومعدَّات عسكرية – وذلك على أمل أن يُنهي من خلال الانخراط في سوريا أيضًا العزلة الدولية المفروضة عليه نتيجة ضمِّه شبه جزيرة القرم قبل عام من ذلك. وقد منحت دمشقُ موسكو الحقَّ في أن تستخدم هذه الأخيرةُ – بشكل مجاني وإلى أجل غير محدود – مطارَ حميميم الواقع جنوب شرق اللاذقية، والذي وسَّعه بوتين إلى قاعدة جوِّية روسية تستطيع الهبوط فيها الآن قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية.
والإمداد بالأفراد والأسلحة يتم أيضًا عبر القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، والتي تحتفظ بها موسكو منذ عام 1977. وهي منفذ روسيا الوحيد إلى البحر الأبيض المتوسِّط وتعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وذلك لأنَّ بوتين يريد استخدامها في منع هيمنة حلف الناتو على البحر الأبيض المتوسِّط. ومن طرطوس انطلقت مؤخرًا السفن الحربية الروسية باتجاه أوكرانيا، وبالتالي فإنَّ موسكو باتت تستخدم هذه القاعدة بهدف مواجهة توسُّع حلف الناتو.
لقد تغيَّر الوضع في عام 2015 مع دخول روسيا الحرب إلى جانب الأسد. وبما أنَّ بوتين قد تدخَّل بطلب من دمشق فإنَّ انتشار قوَّاته في سوريا لا ينتهك القانون الدولي – بعكس حربه العدوانية الحالية على أوكرانيا. غير أنَّ انتهاكه القانون الدولي يتجلى في طريقة قيادته الحرب. فسلاح الجو الروسي يقصف مناطقَ سكنيةً في سوريا من دون مراعاة المدنيين وكثيرًا ما تم توثيق استهداف غاراته المستشفيات والمدارس والأسواق وكذلك استخدامه القنابل الحارقة والذخائر العنقودية والقنابل الفراغية في مناطق مدنية وهذا لا يبشِّر بالخير بالنسبة لشعب أوكارانيا.
وتُقدِّر منظمة إيروارز Airwars غير الحكومية، التي تُوثِّق الغارات الجوية لجميع الأطراف المتحاربة في سوريا مقتلَ أكثر من ثلاثة وعشرين ألف مدني بسبب روسيا، بينما تدَّعي موسكو عدم تضرُّر أي مدني نتيجة غاراتها.
وهذا التناقض الصارخ يزيد من أهمية أداة بوتين الثالثة – أي نشر المعلومات المضللة. فهو يستخدم أحيانًا الدعاية البشعة من أجل تشويه سمعة خصومه ولتبرير تصرُّفاته الخاصة.
Putin hat in Syrien über Jahre hinweg gezielt Schulen und Krankenhäuser bombardieren lassen. Warum sind immer noch so viele Menschen über seine Brutalität überrascht?
— Maximilian Popp (@Maximilian_Popp) February 24, 2022
التغريدة: يستهدف بوتين منذ سنوات عديدة بغاراته وقنابله المدارس والمستشفيات في سوريا. فلماذا لا يزال الكثيرون يندهشون من وحشيته؟
أمَّا اتهامه أوكرانيا بارتكابها “انتهاكات وإبادة جماعية” فهذا ليس مفاجئًا لمراقبي سوريا. فعلى سبيل المثال يقوم الكرملين منذ عام 2016 بالتحريض ضدَّ منظمة الدفاع المدني التطوُّعية السورية “الخوذ البيضاء” – الحاصلة على جائزة نوبل البديلة والتي توثِّق بواسطة كاميرات محمولة ومثبَّتة على الخوذ عمليات الإنقاذ التي تقوم بها. وهذا يجعلها خطيرة بالنسبة لروسيا – فمقاطع الفيديو التي تنشرها هذه المنظمة تعرض بانتظام المدنيين ضحايا الغارات الصاروخية الروسية.
ومن محاولات روسيا الوقحة أيضًا اتهام الآخرين بجرائم الأسد وإلباسهم بها وكأنها ارتُكِبَتْ تحت “راية مزيَّفة” للأسد. وقد حقَّقت في ذلك نجاحًا مخيفًا خاصة في استخدام الأسلحة الكيماوية. فحتى عندما استنتج محقِّقو الأمم المتَّحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) – مثلما حدث في حالة الهجوم بغاز السارين في شهر نيسان/أبريل 2017 على بلدة خان شيخون – أنَّ دمشق كانت هي المسؤولة عن الهجوم بهذا الغاز السام، فما تزال تنتشر وبكلّ صلابة في الرأي نسخٌ أخرى عن هذا الهجوم، وذلك لأنَّ روسيا ترفض التحقيقات باعتبارها غير جادة ولا تزال تقدِّم ادعاءات غامضة حتى يومنا هذا. لقد أتقن بوتين في سوريا الاستراتيجية الإعلامية المتمثِّلة في نشر العديد من الروايات والتناقضات حول حدث معيَّن لكي تبدو الحقيقة في آخر المطاف مجرَّد واحدة من نسخ عديدة ممكنة.
ثانيًا: بوتين تكتيكي وليس استراتيجي
لم تكن توجد لدى الرئيس الروسي في عام 2011 أية إستراتيجية طويلة الأمد من أجل سوريا، على الرغم من أنَّ الأمر قد يبدو كذلك عند النظر إلى الماضي. فقد جاء قرار إبقاء بشار الأسد في السلطة بعد استعراض الناتو عضلاته في المنطقة، وخاصة في ليبيا.
لقد مكَّن امتناع موسكو في شهر آذار/مارس 2011 عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتَّحدة حلفَ الناتو من التدخُّل في ليبيا، والذي قصف بدوره بعد وقت قصير نظام معمر القذافي وأخرجه من الوجود، على الرغم من أنَّ هذا التدخُّل كان يهدف فقط بحسب تفويض الأمم المتَّحدة إلى حماية المدنيين.
وهكذا قرَّر بوتين أنَّ هذا لن يحدث أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف في سوريا. فالأسد هو في آخر المطاف آخر حليف لموسكو في الشرق الأوسط بعد أن كانت المنطقة قد سقطت كلها تقريبًا تحت النفوذ الأمريكي على مدار العقد الأوَّل من القرن الحادي والعشرين.
ولذلك فإنَّ خطة بوتين من أجل دمشق تقتصر على منع أي تغيير مدعوم من الغرب في النظام السوري.
لقد طوَّر رئيس الكرملين نفسه ليصبح أقوى نصير يحمي الأسد، وبات لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لجميع الأطراف المعنية وصار في النهاية يمسك بزمام الأمور في يده.
وبوتين لا يتَّبع في ذلك أية حسابات ثابتة، بل يتفاعل مع الأحداث الجارية – والتي كلما كانت أكثر ديناميكية كان ذلك بالنسبة لبوتين أفضل. وذلك لأنَّه يستطيع بصفته حاكمًا سلطويًا متهوِّرًا أن يستخدم كلَّ أزمة لصالحه، في حين يتعيَّن على السياسيين الغربيين أخذ الرأي العام في عين الاعتبار وإشراك برلماناتهم والتصويت على أي عمل.
وهكذا استطاع بوتين في شهر أيلول/سبتمبر 2013 تنفيذ انقلابه التكتيكي الأكبر. فبعد الهجمات بالغازات السامة على مناطق في ريف دمشق بتاريخ الـ21 من آب/أغسطس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف وأربعمائة شخص، كان الرئيس الأمريكي أوباما مضطرًا إلى فعل شيء. فقبل ذلك بعام واحد فقط كان قد وصف استخدام الأسلحة الكيماوية بالخطّ الأحمر، ولكنه بات يريد الآن أن يتجنَّب على أية حال القيام بضربة عسكرية بسبب خشيته من احتمال تورُّط الولايات المتَّحدة الأمريكية في حرب أخرى.
وساعده بوتين في الخروج من مأزقه هذا. فقد ألزم النظامَ السوري بالتخلُّص من أسلحته الكيماوية بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقد قدَّم بوتين بذلك لأوباما ذريعةً مُرَحَّبًا بها لعدم قيامه بهجوم. وبدلًا من معاقبة الأسد على قتل مئات المدنيين بالغاز، أصبح شريكًا وحصل بعد ذلك بوقت قصير مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام وبدا بوتين بمثابة مدير أزمات بالإمكان الاعتماد عليه.
يتنهز بوتين أية فرصة للعمل فور ظهورها لأنَّ الأطراف الفاعلة الأخرى – وخصوصًا الغربية – تترك فجوة. وبالتالي يجب من أجل إدارة الصراع مع بوتين عدم التردُّد، بل السير بطريقة مُتَّسقة ويمكن التنبؤ بنتائجها.
ثالثًا: بوتين لا يبالغ في تقدير حجمه
ومهما كان ما تقوم به روسيا في سوريا فإنَّ بوتين يعرف حدوده. وسوريا بعكس أوكرانيا بعيدة جغرافيًا وعاطفيًا بالنسبة لمعظم المواطنين الروس. وبالتالي فإنَّ التدخُّل الروسي في سوريا لا يتمتَّع باهتمام شعبي واسع وبوتين يحرص على التقليل من خسائره. وقد اقتصر منذ البداية مهمته على المستشارين العسكريين والقوَّات الجوية وبعض وحدات البحرية والقوَّات الخاصة – بمن فيها مرتزقة مجموعة فاغنر – وهي شركة أمنية خاصة مقرَّبة من الكرملين وقد تم استخدامها أيضًا في شبه جزيرة القِرْم.
أمَّا الحرب على الأرض فهو يتركها للآخرين وعلى رأسهم إيران، التي تقوم بتشكيل قوَّات الدفاع الوطني السورية على غرار الحرس الثوري الإيراني. وهذه القوَّات تستعيد السيطرة على مناطق المعارضة لصالح الأسد، ولكن هذه المناطق يمكن أن تضيع من دون الدعم الجوي الروسي. ومن هذه الناحية، يقدِّم بوتين ومن دون المخاطرة بالكثير ما يحتاجه النظام بالضبط: الخبرة والتكنولوجيا الحديثة بأقل تكلفة بشرية ممكنة.
ومن خلال اختبار أنظمة الأسلحة الجديدة في سوريا، فقد زاد الجيش الروسي عدد مبيعاته من هذه الأسلحة وقام بتحديث نفسه. وهكذا فقد أثبتت المهمة الروسية في سوريا أنَّها في حالة تأهُّب عسكري تقني مفيد من أجل الهجوم على أوكرانيا.
رابعًا: بوتين يتصرف بطريقة براغماتية ومرنة
تتميز الحرب السورية أكثر من أي صراع آخر بتغيير التحالفات. إذ إنَّ القوى المتدخِّلة لا تلتزم بتحالفات طويلة الأمد، بل تدخل في تحالفات مصالح قصيرة الأمد من أجل فرض مصالحها الخاصة. وبوتين خبير في هذه اللعبة.
وبعد سنوات من التعاون الدبلوماسي مع الولايات المتَّحدة الأمريكية، أطلقت موسكو مبادرة جديدة في مطلع عام 2017 في العاصمة الكازاخستانية أستانا. فقد بات بوتين يراهن على التفاهم مع القوَّتين الإقليميتين إيران وتركيا، لأنَّ المحادثات مع واشنطن في عهد دونالد ترامب لم تكن مجدية، في حين أنَّ الأوروبيين، الذين لم تكن لديهم أية استراتيجية واستعداد للعمل، لم يكن لديهم على أية حال أي رأي في سوريا.
لقد تعيَّن على الأطراف المتحاربة الثلاثة الأكثر نفوذًا نزع فتيل الصراع من أجل زيادة فرص المفاوضات. وتحوَّل وقف إطلاق النار إلى “مناطق لتخفيف حدة التصعيد”، ولكنها مع ذلك لا تستحق هذا الاسم لأنَّ روسيا وإيران واصلتا القتال إلى جانب الأسد مثل السابق، في حين فتحت تركيا في مطلع عام 2018 جبهةً أخرى ضدَّ الأكراد في شمال سوريا.
ووجد بوتين في الرئيس التركي إردوغان شريكًا في الصراع. فهما يلعبان كلاهما بِرهانات عالية في سوريا ويحبان الإيماءات الدرامية، ولكنهما قادران عند الضرورة على الحفاظ على برودة أعصابهما. أدار إردوغان ظهره لصديقه السابق بشار الأسد في بداية الانتفاضة السورية وبات يُموِّل الميليشيات الإسلامية منذ سنوات – وبالتالي فإنَّ تركيا وروسيا يقفان في الصراع على جانبين متعاديين.
وعلى الرغم من ذلك فهما يتعاونان. ففي إدلب وعد بوتين بوقف خطط استعادة الأسد سيطرته عليها حتى لا يستمر ملايين النازحين داخليًا في مواصلة نزوحهم باتجاه تركيا، بينما كان من المفترض أن يتولى إردوغان إحتواء الجهاديين. ولكنهما لم ينجحا. وفي شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، يقوم الجنود الروس والأتراك بدوريات مشتركة من أجل الحفاظ على المنطقة العازلة بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية. ولكن كثيرًا ما تقع هنا أيضًا اشتباكات.
وهذه العلاقة شديدة التعقيد وكثيرة التوتُّرات بين الحاكمين المستبدين تسير فقط لأنَّهما يُفكِّران بطريقة براغماتية للغاية. وهكذا يحُول بوتين وإردوغان بانتظام دون تأثير الاشتباكات العسكرية في مكان ما على علاقاتهما في أماكن أخرى داخل سوريا. ومن هذه الناحية فإنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو مجرَّد اختبار تحمُّل تم التدريب عليه جيدًا بالنسبة لهما. وحقيقة تزويد تركيا الجيش الأوكراني بطائرات قتالية من دون طيَّار ضدَّ الاعتداءات الروسية لن تغيِّر شيئًا في العلاقات المتناقضة ولكن المستقرة بين موسكو وأنقرة.
وبعد أحد عشر عامًا من الحرب في سوريا، أصبح بوتين في وضع مريح: حيث يوجد في دمشق حاكم خاضع له في تبعية المعترف بالجميل وستتجه إليه مرة أخرى أجزاء كبيرة من العالم. ولذلك فإنَّ مصالح روسيا في الشرق الأوسط تبدو مضمونة.
أما الوضع في أوكرانيا فمختلف تمامًا: إذ يوجد في كييف رئيس يسعى إلى قيادة بلاده نحو الغرب. والفرق الأكبر بين النزاعين بالنسبة لبوتين هو عامل الوقت – ففي سوريا يعمل الوقت لصالحه بينما يعمل في أوكرانيا ضدَّه. ولهذا السبب فقد تحرَّك الآن – بشكل حازم ووقح وواثق من أنَّ الغرب لن يتدخَّل في أوكرانيا تمامًا مثلما فعل في سوريا.
كريستين هيلبيرغ
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: موقع قنطرة 2022
ar.Qantara.de
—————————

السوريون والغزو الروسي لأوكرانيا/ عمر كوش
لم يكن مستغرباً أن السوريين هم من أكثر شعوب المنطقة تفاعلاً واهتماماً بالغزو الروسي لأوكرانيا وإرهاصاته، نظراً لاعتبارات وحيثيات عديدة دفعتهم إلى أن يتابعوا بحماسة – وما يزالون – مجريات وأحداث العمليات العسكرية الدائرة فيها. وجاءت مواقف غالبيتهم مرتكزة على الترابطات والتقاطعات ما بين الأوضاع في كل من سوريا وأوكرانيا، ومحمولة بشكل خاص على موقف النظام الروسي من النظام السوري والقضية السورية، فانطلقوا في تحديد مواقفهم من اعتبار أن نتائج الغزو ستنعكس على أوضاع بلادهم وناسها، سواء في حال انتصار نظام بوتين ونجاحه في احتلال أوكرانيا وتغيير النظام السياسي فيها، أم في حال هزيمته أو استنزافه وغرقه في “المستنقع الأوكراني”.
وعلى الرغم من الاختلافات والفوارق العديدة ما بين ظروف وأسباب التدخل العسكري الروسي المباشر إلى جانب نظام الأسد، والمستمر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2015، والغزو الروسي الحالي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 من فبراير/ شباط الماضي، والتي تطول أبعاداً جيوسياسية وأمنية متعددة وغيرها، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا شكل مناسبة لسوريين كثر، كي يُذكروا العالم بما جرى في بلادهم خلال السنوات الماضية، وللوقوف على أوضاعهم الكارثية، في حين أظهرت مواقف عموم السوريين من الغزو مدى الانقسام الحاصل بينهم منذ قيام الثورة السورية في 2011، والذي ازداد عمقاً مع إطالة أمد الكارثة السورية وتداعياتها، فالمهجرون والنازحون والمعارضون لنظام الأسد لم يخفوا تضامنهم مع الشعب الأوكراني، والوقوف إلى جانب تطلعاته في الخلاص من إرث التبعية لروسيا ونظامها الاستبدادي، واعتبروا الغزو الروسي عدواناً على الدولة الأوكرانية، مع إطلاقهم العنان لتمنياتهم بهزيمة النظام الروسي، بوصفه قوة احتلال لبلادهم وعدواً مباشرا لهم، في حين أبدى رغبته في القتال إلى جانب الشعب الأوكراني. ولا يعدم واقع الحال من وجود شرائح من السوريين غير مكترثة إطلاقاً بالغزو الروسي، لأن همها الأساسي يتمحور حول كيفية الحصول على الغذاء والدواء والتنعم بقليل من الدفء والأمان.
وبالمقابل، سارع أتباع نظام الأسد والموالين له إلى إبداء مواقف مؤيدة للغزو الروسي، وراحوا يتغنون برموز النظام الروسي، وتمنوا الانتصار لجيشه الغازي، ولم يخفِ بعضهم استعداده للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب القوات الروسية الغازية، في حين لم تغب عن أبواق النظام إظهار هلوسات تحاول التسويق لصفقة أميركية مزعومة، تقوم على مقايضة سوريا بأوكرانيا، والتي رفضها “الحليف الروسي”، نظراً للدور البطولي والخارق لنظام الأسد، ولحجم نفوذه المزعوم إقليمياً ودولياً، ويحار المرء من أمره، هل يسخر أم يحزن حيال مثل هذه الهلوسات والتهيؤات.
وكان طبيعياً أن يسارع مجرم الحرب، بشار الأسد، إلى تأييد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن يؤكد على عضويته في عصابة الإجرام التابعة لبوتين، المتمثلة في رمضان قديروف في الشيشان وألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا والانفصاليين في جورجيا ومولدافيا ودونيتسك ولوغانسك في شرقي أوكرانيا، لكنه أبى إلا أن يتمادى في افتراءاته ودجله تأكيداً لولائه وتبعيته لبوتين، بوصفه المجرم الأكبر، من خلال تقليد بوتين في وصفه الحكومة الأوكرانية المنتخبة بـ”النازية”، واعتباره الغزو الروسي “تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم، الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفييتي”.
أما مستشارة الأسد الخاصة، بثينة شعبان، فلم تتأخر عن الإعراب عن تضامنها مع الغزو الروسي وإيجاد مبررات له، حيث اعتبرت أن “الحرب في أوكرانيا لها علاقة بتراكمات العلاقة الروسية الغربية، والتي تعود لنصف قرن، وخسارة روسيا كانت ستكون أكبر بكثير لو لم تتخذ هذا القرار ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا”، في حين أن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، راح يتحدث عن أن “حملة الغرب المضللة ضد روسيا، تشبه الحملة التي شنتها هذه الدول على سوريا”، بينما سارعت المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، لونا الشبل، إلى الزعم بأن نظام الأسد سيقوم برد الجميل إلى روسيا من خلال دعمها “للتغلب على العقوبات، كما فعلت موسكو مع دمشق”، في حين أن القاصي والداني يعرف أن هذا النظام غير قادر على تأمين مستلزمات العيش الضرورية في المناطق التي يسيطر عليها، وأنه يعتاش على الدعم والمساعدات التي تقدمها كل من روسيا وإيران، وعلى ما يجنيه من عمليات تهريب المخدرات إلى دول الجوار.
وفي حين تأمل هيئات من المعارضة السورية أن يسهم الموقف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في تحريك الملف السوري مجدداً، وفي دفع دول الغرب إلى إعادة النظر في مقاربتها له، من خلال تفعيل آليات وممارسة ضغوط كبيرة على النظام الروسي، إلا أن الائتلاف السوري المعارض اكتفى بدعوة العالم إلى التصدي للغزو الروسي على أوكرانيا، والتحذير من أن الشعب السوري لا يريد أن يشهد “مزيدا من الإجرام الروسي المقترن بخذلان دولي في أي جزء جديد من العالم، بعد ما عانى وما يزال من مجازر روسيا وجرائمها في سوريا”. أما قوى الواقع الكردية التي تسيطر على مناطق الجزيرة السورية، فلم يصدر منها أي موقف يُذكر، بالرغم من ترقب وقلق قياداتها من نتائج الغزو، التي قد تترك آثارها على مشروعها في الإدارة الذاتية، وعلى استمرار سيطرتها على مناطق غنية في الشمال السوري.
ولا يفترق السوريون عن شعوب أخرى في العالم في متابعتهم لأحداث الغزو الروسي، سواء من خلال تغطية وسائل الإعلام، أم من خلال التفاعل الكثيف على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن مآسي الأوكرانيين ومشاهد الدمار والقصف وموجات النزوح والتهجير في أوكرانيا، أعادت إلى أذهان غالبيتهم صور ما حلّ بهم وببلادهم من جراء الهجمات التي قامت بها القوات الروسية، عندما تدخلت – وما تزال – في الحرب البشعة إلى جانب نظام الأسد ونظام الملالي الإيراني ضدهم، والتي أفضت إلى تحويل معظم مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى خرائب، وإلى تهجير أكثر من نصف السوريين من أماكن عيشهم وسكناهم.
ولا شك في أن سوريين كثر يشعرون بالإحباط وبالمرارة من التعامل الدولي، وخصوصاً الغربي، مع قضيتهم، وتولدت لديهم سردية حيال حيثيات وأسباب معاناتهم ومآسيهم، التي ساهم نظام بوتين في تعميقها من خلال تدخله العسكري البربري إلى جانب نظام الأسد، إضافة إلى صمت الغرب عن جرائمه ومجازره التي ارتكبها ضد غالبية السوريين، وبالتالي من الطبيعي أن يصور معارضو الأسد بوتين بوصفه عدواً للشعبين السوري والأوكراني، وأن يجنح بعضهم إلى عقد مقايسات ومقارنات بين معاناتهم ومعاناة الأوكرانيين، وانتهاز الفرصة للتذكير بسياسة الكيل بمكيالين، في محاولة لاستدرار التعاطف العالمي مع قضيتهم، بوصفهم ضحايا عنجهية بوتين ونظامه، لكن الأمر مرهون بما ستؤول إليه المعارك في أوكرانيا، التي قد تؤثر نتائجها ليس على القضية السورية فقط، بل على أوروبا والنظام العالمي برمته.
—————————–
مقارنات سورية مع الحرب الأوكرانية/ حسام جزماتي
يحصل أن يستخدم سوريون معارضون تعبير «سوء الحظ» ليلخصوا المسيرة المعقدة المتعثرة لثورتهم واستعصاءها الحالي بعد أكثر من عقد. كما أن الأيام القليلة الماضية شهدت مقارنات بين ردة فعل الغرب على الحرب الروسية على أوكرانيا وعلى التدخل العسكري الروسي في سوريا. ففي حين انهالت الأسلحة لدعم الحكومة الأوكرانية بشكل فوري؛ فإن الطائرات الروسية التي تقصف مناطق المعارضة السورية دخلت عامها السابع من دون محاسبة. وقد تجاوزت المقارنات موضوع سوء الحظ لتصل إلى الموازنة بين الضحية السمراء وتلك البيضاء، ولتتهم العالم بالكذب في ادعائه احترام حقوق الإنسان. لا سيما بعدما توسع الحصار الأميركي الأوروبي لروسيا ليشمل شركات ومصارف وأنظمة عالمية ورياضات…
وإن كان من الوارد استقراء بعض معالم الحظ العاثر الذي واجهته احتجاجات السوريين بالفعل، فالمصادفات السيئة جزء من التاريخ كذلك؛ فإن أغلب ما يتم اختزاله عادة تحت هذه الكلمة القدرية العريضة «الحظ» هو مما يمكن تفكيكه إلى معطيات قابلة للتعقل والفهم ولو بعد قدْر من التأمل.
فقد أصبح من المعروف، حتى لمتابعي التحليلات التلفزيونية السريعة، أن الحرب الروسية الأوكرانية قامت على فالق بين شرق بوتيني متغطرس، يمزج الستالينية بالأرثوذكسية، وبين غرب كانت أوكرانيا تتحرك باتجاه أن تكون قلعته المتقدمة على حدود روسيا، بسعيها إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو. ومن هنا فإن مبادرة الغرب إلى الدفاع عن أوكرانيا بأشد الوسائل الممكنة، وبشكل غير مسبوق، هي دفاع عن دولة موالية وجزء شبه عضوي منه. أما السوريون فهم متفقون على مزاج معاد للغرب على العموم، يتشابه في هذا مؤيدو النظام وجمهور الثورة. سوى أن الأخيرين مروا بأشهر قصيرة من التعويل على الغرب لإنقاذهم من المقتلة الأسدية، في أواخر 2011 ومطلع 2012، قبل أن يفقدوا الأمل بسرعة ويرتكسوا إلى خطابهم العام المألوف في انتقاد الغرب، والمؤصّل عبر الضخ الآيديولوجي لمختلف التيارات المؤثرة تاريخياً فيهم؛ الإسلامية والقومية والماركسية، وتعلن أغنيتهم الثورية «حنّا ما نحتاج النيتو».
لكن الأعمق من ذلك هو ما لم تحمله الأهازيج المعتدة، بل جملة مفتاحية وردت في الكلمة الأولى التي خاطب بها أبو محمد الجولاني السوريين، في الإصدار الذي أعلن عن ولادة «جبهة النصرة لأهل الشام»، في كانون الثاني 2012، وهي أن تداعي «المجاهدين» للتدخل في سوريا إنما جاء، بعد «نزيف الدم الهائل»، لمنافسة طلب سوري للتدخل الخارجي مما هو، في رأيه عندئذ «استعانة بالعدو الغربي للخلاص من العدو البعثي، وهي دعوة شاذة ضالة وجريمة كبرى ومصيبة عظمى لا يغفرها الله ولن يرحم أصحابَها التاريخُ». ومن هنا جاء تأسيس الجبهة لتكون «سلاح هذه الأمة في هذه الأرض، وتغني الناس بعد الله عن استنصار الغرباء القتلة».
لا يعني هذا إلقاء اللوم على متهم وحيد هو «جبهة النصرة». فالمشكلة أن الجبهة لم تصبح بطة سوداء بين القوى العسكرية المعارضة المتشكلة في ذلك الوقت، بل أصبحت «المنارة البيضاء» التي جذبت «الساحة» إلى خطابها. ومن الصعب هنا استعراض أبرز معالم هذا التأثير المتنوع على فصائل الجيش الحر الآخذة بالتأسلم، حتى ظهور داعش من قلب «النصرة» وتجاوزها بخطاب معاد كلياً للعالم، لم يمر من دون أتباع وتأثير. وقد جرى كل ذلك في وقت كان الغرب فيه يدرج هذه التنظيمات وقادتها على قوائم الإرهاب، في حين نحن نطالبه بالسلاح الذي قد يقع بسهولة في مخازن حركات معادية له بوضوح، بغرف عمليات علنية، أو شراكات سرية، طوعية وقسرية، مع فصائل من الجيش الحر، أو بالاعتداء عليها لسلبها الدعم الذي وصل إليها من الخارج.
ولا يعني هذا أننا المسؤولون الوحيدون عن سوء حظنا، وأن أحداً كان متحمساً للتدخل العسكري لصالحنا أصلاً. وقد قيل كثير عن تلكؤ الأوبامية وتقاعسها ونتائجه الكارثية. غير أن الغرب نفسه يصرّح اليوم أنه لن يتدخل مباشرة، مع إغداق الأسلحة والذخائر لسلطات يعرف أنها لن تدير ببندقيتها باتجاهه. في حين مرّت سنوات على الثورة السورية تراجع فيها علمها الأخضر وارتفعت راية العُقاب، المعتمدة لدى «القاعدة»، وإن بتدرجات مختلفة. وصار الفصيل الذي يوصف بأنه «علماني» هو البطة السوداء حقيقة، في ظل تشكيك بمشروعه و«شرعيته» وارتباطاته ونيّاته وعناصره «المفحوصين» غربياً.
وقد أسهم ذلك، بالإضافة إلى تعدد مريع في الفصائل المعارضة، واعتداد كل ذي جعبة بطلقته، إلى استخفاف المسلحين بالمعارضين السياسيين، في المجلس الوطني ثم الائتلاف، مما أضعف موقف هؤلاء التمثيلي أمام العالم وأشاع الاستهانة بهم حتى وصلت إلى المستوى الراهن. في حين تقود أوكرانيا سلطة منتخبة تسيطر على الجبهات عبر وزارة دفاع حقيقية، ولا تبدو في أعلى هرمها معالم الشقاق كما في معارضتنا السياسية.
لقد ردد الجميع أن الدول ليست «جمعيات خيرية»، وأنها لا ترسل جيوشها لأجل «سواد عيون» أحد. لكننا لم ندرج هذه العبارات في وعينا الفاعل، وظل طلبنا العون من «العالم» أشبه باتصالٍ آمرٍ بمطعم للوجبات السريعة، دون أن نتعهد حتى بتسديد أي ثمن، مهددين في كل مرة أننا سنفضح «نفاق» الغرب وسياسته في «الكيل بمكيالين» إن لم يصل الطلب في الوقت المحدد، حاراً.
بالتأكيد هناك مؤشرات متناثرة على انحياز أبيض، حضاري وثقافي، في الغرب، غير أن ذلك لا يصنع الحروب اليوم. فالدول الغربية لا تتدخل، أيضاً، لأجل زرقة عيون أحد أو خضرتها. وهي تخوض معركتها الخاصة حين تدعم أوكرانيا بكل السبل.
تلفزيون سوريا
———————–
أوكرانيا وسورية وهذا اليسار/ سعد كيوان
أحدث غزو روسيا أوكرانيا زلزالاً في نظام عالمي كان على مفترق طرق، وستبقى ارتجاجاته تتفاعل ربما عقوداً. ليس لأن ما فعله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشكّل، بحد ذاته، مفاجأة أو سابقة، بل لأنه، بالمعنى الاستراتيجي وحساب موازين القوى، قد تمادى أكثر، متخطّياً الحدود والدور الجيوبوليتيكي الذي رسمه لنفسه. لقد غرز بوتين السكين في خاصرة أوروبا التي يسعى لأن يكون جزءاً منها ومؤثّراً فيها، ولكنه ينتمي بنيوياً وثقافياً إلى عالم آخر. وهو نتاج منظومة أيديولوحية وقيم تغلّب السلطة على الحرية، وهو الصاعد إلى السلطة من أروقة أجهزة المخابرات. ويعتقد أنه وريث الإمبراطورية السوفييتية التي تدغدغ كبرياءه ويحلم بإعادة إحيائها، أقله من خلال استعادة الهيمنة على الدول التي تحيط بروسيا مباشرةً، كما دأب يفعل منذ سلّمه بوريس يلتسين، الروسي جداً، الحكم في 1999. وقد أثبتت ذلك شخصية الرجل المركبة والمعقدة والمغرقة بعظمة القومية الروسية، ومسيرته الطويلة التي بدأت قبل أكثر من عشرين سنة، والتي قامت على التفرّد بالسلطة، وتعزّزت وتغذّت بالحروب والبطش، بدءاً من إخضاع “الإرهابيين” الشيشان الذين يتقدّمون اليوم فرق جيشه الذي اجتاح أوكرانيا، ليبدأ بعدها مسلسل التوسع عام 2008 بغزو جورجيا التي استعادت استقلالها عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومحاولة إخضاعها بفرض انفصال إقليمَي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا واعترافه بهما دولتين مستقلتين، ثم تقدّم عام 2014 إلى سلخ شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وضمها إلى روسيا، تبعها تحريض منطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين تتكلمان اللغة الروسية، في إقليم دونباس شرقيّ البلاد، من أجل الانفصال، وسارع إلى الاعتراف بهما عشية غزوه أوكرانيا. وكلّل بوتين حلمه كدولة عظمى بالتمدّد خارج حدود الاتحاد السوفييتي السابق نحو الشرق الأوسط عام 2015 بالسيطرة على سورية وقمع ثورة الشعب السوري الذي انتفض على حكم الاستبداد الأسدي. ويحكم اليوم قبضته على السلطة والجيش، مقيماً القواعد العسكرية البرية والجوية والموانئ الحربية في طول البلاد وعرضها، ويرسل مرتزقة إلى ليبيا والسودان، ويغازل إسرائيل ويطلق سلاحها الجوي في سماء سورية ضد إيران حليفه اللدود وذراعها المليشياوي، حزب الله. وها هو اليوم يستدير نحو أوروبا الغربية، وهدفه تحدّي الولايات المتحدة.
هل هو الشعور بفائض القوة؟ لقد تعامل الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة، مع بوتين على اعتبار أن الدول المحيطة، مثل جورجيا وبيلاروسيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها، بمثابة “الحديقة الخلفية” لموسكو، ومثالاً، ما حصل قبل أشهر مع بيلاروسيا، إذ أرسل بوتين قوات لقمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد حكم ألكسندر لوكاتشنكو الذي يجدّد، مثل بوتين، لنفسه في السلطة منذ أكثر من عشرين سنة. يُسقط الكرملين حكماً ويغيّر آخر في هذه الدول، ويضبط إيقاعها على ساعته، ويفعل فيها ما يشاء، ما عزّز لديه شعوراً بالعظمة وبنشوة السلطة. وكانت العواصم الأوروبية تتعاطى معه بالمفرّق، فمنها من صادق، ومنها من تواطأ، ومنها من استخفّ، أو غلّب مصالحه التجارية. وهذا، إلى حد ما، طبيعي في العلاقات بين الدول. كان تعاطي برلين وباريس ولندن نابعاً من اعتبارها أن روسيا تبقى وريثة الاتحاد السوفييتي، وبالتالي، تبقى عملياً زعيمة تلك المجموعة من الدول في أوروبا الشرقية وآسيا، أي إنها ما زالت جزءاً من المنظومة الروسية، وتدور في فلكها، تماماً مثلما كانت تتعامل واشنطن مع دول أميركا اللاتينية التي كانت تعدّها حديقتها الخلفية، حيث نصبت ودعمت، عشرات السنين، أنظمة حكم عسكرية وفاشية، قمعت مواطنيها ونكّلت بهم، غير أن بوتين الذي ورث إمبراطورية منهكةً ومفكّكة ومعذّبة، راح ينفخ في الاتحاد الروسي روح التعصب القومي، بدل الحرية والتعدّدية، محاولاً الجمع بين أمجاد روسيا القيصرية والاستبداد السوفييتي، فيما انصرفت الجمهوريات السوفييتية السابقة إلى استعادة استقلالها وإعادة بناء دولها على أسس ديمقراطية، وانتهاج سلوك تصالحي مع شعبها.
وتحوّل بوتين تدريجاً إلى حاكم بأمره، يمركز السلطات ويحصرها بشخصه، متنقلاً بين رئاستي الدولة والحكومة، ويطلق العنان للقمع والاستبداد وزجّ معارضيه في السجون مقابل تحصين سلطته وتأبيدها، عبر تعديل الدستور وتفصيله على قياسه، وتنصيب نفسه ديكتاتوراً لغاية عام 2036. غير أنه، بوصفه رجل استخبارات سابقاً، يستعمل بحنكة خطاب الحكم السوفييتي السابق وأساليبه، ويلعب على عواطف الجمهور الواسع الذي ما زال الحنين يشدّه إلى الحقبة الشيوعية، ليس في روسيا والمحيط فقط، بل في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك القارّة العجوز، من قوى وتنظيمات يسارية متطرّفة وبقايا أحزاب شيوعية تعتقد أن روسيا ما زالت دولة شيوعية ومعادية للإمبريالية، وترى في بوتين نصيراً للشعوب المقهورة، إلى درجة أن تعصبّه القومي دفعه إلى محاكمة روسيا البلشفية التي حمّلها مسؤولية فصل جزء من أراضي روسيا التاريخية، ملقياً بالمسؤولية على لينين نفسه الذي عمل ضد مصالح روسيا، وكذلك ستالين الذي عزّز اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية وحصّنه، عبر نقله ملكية بعض الأراضي إلى أوكرانيا.
كما يعتقد كثير من جمهور “محور الممانعة” العربي الذي هلّل للتدخل العسكري الروسي لإنقاذ نظام الأسد من السقوط في خريف 2015 أن القيصر الروسي أجبر الإمبريالية الأميركية على الانكفاء عن سورية. وفي الحقيقة، مارس بوتين الخديعة مع الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عندما أقنعه في صيف 2014 بعدم قصف دمشق مقابل أن يسلّم الأسد سلاحه الكيماوي الذي استعمله في الأسابيع التي سبقت ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، وأوقع نحو 1500 قتيل. إلا أن هذا “الجمهور الممانع” الذي هو مزيج من قوميين ويساريين وخمينيين، يناصر الأسد والجرائم التي يرتكبها، وبالأخص قصفه الشعب السوري بالبراميل المتفجرة لتطهير المدن من “خلايا الارهاب الداعشي”، وهو لذلك يتعرّض لـ”مؤامرة كونية”، تقودها الولايات المتحدة والغرب الاستعماري. وبوتين، في نظرهم، هو المنقذ الذي ارتكب جيشه في نهاية 2016 مجازر حلب وأمّن الغطاء الجوي لكتائب الأسد والمليشيات الإيرانية التي ارتكبت يومها الفظائع، غير أن بوتين لم يرَ حرجاً في الازدراء بمسألتين أساسيتين للشعوب العربية، أي فلسطين والتوق إلى الحرية، فأقام أوثق العلاقات مع إسرائيل، وكان يستقبل بنيامين نتنياهو بشكل شبه شهري منذ حطت مقاتلات سلاح الجو الروسي على أرض سورية، ووقوفه إلى جانب النظام ضد انتفاضة السوريين من أجل حريتهم وكرامتهم.
وساق بوتين الحجّة نفسها لاجتياح أوكرانيا من أجل تطهير الحكم ممن أسماهم، في خطابه عشية الغزو، “النازيين الجدد ومدمني المخدرات”. وفي أوروبا، تبنّت تنظيمات يمينية عديدة، قومية وعنصرية ويسارية متطرفة، هذه الكذبة وهلّلت للغزو الروسي، وهي تخشى الآن أن تصل الحرب إلى دارها وتتظاهر ضدها، وتعتبر أن حكوماتها هي التي استفزّت موسكو “في عقر دارها”، على اعتبار أن انضمام أوكرانيا ذات الحدود المشتركة مع روسيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكّل تحدّياً وخطراً على أمنها. علماً أن أوروبا لم توافق أوكرانيا أو تعدها بقبول طلبها، إلا أن دول الحلف لم تكن ربما صريحة وحاسمة في رفضها، ودفعت الحكومة الأوكرانية إلى الاعتقاد أنها ستلبي طلبها في مرحلة لاحقة، ما أثار غضب الكرملين. هل كان سلوكاً مقصوداً؟ غير أن بوتين، على الأرجح، قد أساء التقدير، وظن أن عواصم الغرب، وتحديداً واشنطن، ستتعاطى مع غزو أوكرانيا كما تعاطت مع الأزمات السابقة، وتترك له التصرّف كما يشاء في حديقته الخلفية البعيدة آلاف الكيلومترات عنها، تماماً مثلما فعلت في تركه يتدخّل عسكرياً في الساحة السورية، ويصبح اللاعب الأساسي على مسرح الشرق الأوسط الذي له هو تقليدياً مساحة نفوذ للولايات المتحدة. فهل كان توريطاً له في المستنقع السوري؟ كذلك فإن أوروبا من ناحيتها اعتقدت على العكس أن بوتين لن يجرؤ على هذا التحدّي، خصوصاً أن هناك مصالح اقتصادية وتجارية متعدّدة بينهما. قيادات الدول الأوروبية مصابة بالذهول والصدمة. الأكيد أن سلاح بوتين في هذه المواجهة غير المسبوقة هو القدرة العسكرية وعامل الجغرافيا، ولكن الجيوبوليتيك وحساب المصالح على مدى الساحتين، الأوروبية والدولية، ليسا في مصلحته، فضلاً عن ضغط الرأي العام المناهض للحرب والتوسّع ولأنظمة الاستبداد والتسلط، حتى داخل روسيا.
لقد دخلت الحرب أسبوعها الثاني، ولم يحسمها بوتين بعد، وهو سيحسمها في النهاية. ولكن المعركة ليست عسكرية فقط بالمعنيين، الحربي والميداني، فمن نصب فخّاً لمن؟ ومن الذي وقع فيه؟ أم أن أوكرانيا وقعت ضحية الطرفين؟ ما فعله بوتين يجعل من الصعب عليه التراجع عنه والعودة إلى الوراء، وهو يبدو محشوراً في الزاوية، إذ إن الطوق طويل ومحكم بالعقوبات الشاملة والموجعة وغير المسبوقة، إلى درجة أن سويسرا انضمت إليها لأول مرة في تاريخها منذ إعلان حيادها. ويبدو معزولاً بشكل كبير، إلى درجة أن خمس دول فقط وقفت إلى جانبه في الأمم المتحدة، كذلك إن معظم رجال الأعمال والأوليغارشيين الروس الذين اغتنوا من حوله بدأوا ينفضّون عنه!
العربي الجديد
————————————–
ازدواجية المعايير لن تهزم مجرماً/ يحيى العريضي
فجأة، ودفعة واحدة، فتحت المنظومة الدولية “شبه المنافقة” كلَّ دفاتر القبح والإجرام الروسي، لفعْلَتِها في أوكرانيا. سادت هذه الكرة الأرضية أجواء فاقت بتوترها ورعبها أجواء سبقت حربين عالميتين أعادتا تشكيل كل شيء. هذا الاستنفار المفاجئ تجاه روسيا، وشبه الإجماع العالمي على عزلها، وخنقها، وإبراز خطرها، و”هتلريتها”، يكاد يتخذ قراراً بإخراجها من هذا الكوكب؛ وخاصة عندما ادّعى بوتين أنه وضَعَ “النووي” في حالة تأهب.
كل هذا القبح الروسي والجريمة الروسية الموصوفة تم تنفيذه وممارسته لسنوات علنياً في سوريا وعلى شعبها؛ وشَهِدَت هذه المنظومة الدولية ذاتها نتائجه الكارثية، وسَطَ تباهي المسؤولين الروس بأنهم جربوا مئات أصناف الأسلحة على أرواح السوريين، ودرّبوا آلاف المقاتلين والفنيين الروس على الجسد السوري. وما شعر السوريون باستنفار عالمي كهذا؛ وكأن تلك المنظومة العالمية كانت في إجازة؛ بل إن قوى وازنة منها نصحت السوريين بمراجعة الروس بقضيتهم.
صحيح أن القضية السورية تختلف تماماً عن قضية أوكرانيا بالمواقف التي أحاطت بكل منهما؛ فلا توجد إسرائيل على حدود أوكرانيا حريصة على بقاء مَن يحمي حدودها، ولا مَن يهمهم حرص إسرائيل وهواجسها، ويعملون بمشيئتها؛ وليس هناك من سلطات محيطة بأوكرانيا تريد أن تجعل مما حدث للسوريين على يد طاغية درساً لشعوبها، كي لا يأتوا بحركة ضد تلك السلطات؛ ولا مُنِعَ سلاح على الأوكرانيين كما حُرِم السوريون مما يمكن أن يدافعوا به عن أنفسهم؛ وصحيح أن قَدَريّة السوريين ودعاءاتهم وبراعتهم بالشتيمة كانت كثيرة، وأنهم لم يوَفّقوا بمن حمل قضيتهم رسمياً؛ إلا أن الحالتين تختلفان في كل شيء تقريبا، وتتشابهان في نقطة أساسية وجوهرية بأنهما الدريئة والملعب الذي يمارس بوتين إجرامه عليه.
لقد ساد هذا العالم صمت مريب عندما كان بوتين يتذرع بعدم جواز تغيير الأنظمة بالقوة، وبعدم المساس باستقلال ووحدة وسيادة أي بلد؛ كي لا يقترب أحد من نظام إجرامي مستبد قتل شعبه وشرده واستخدم حتى السلاح الكيماوي ضده؛ وها هو بوتين في أوكرانيا يفعل ما نهى عنه، ويعكس الذريعة التي ساقها في الحالة السورية، عندما ينتهك وحدة واستقلال وسيادة أوكرانيا؛ ويريد خلع نظامها المنتخب (بعكس منظومة الاستبداد الأسدية)؛ إلا أن ذلك الصمت المريب تجاه الحالة السورية تحوّل إلى صرخة كونية في الحالة الأوكرانية.
كان بإمكان هذا العالم أن يوفّر على الأوكرانيين، (وربما، وعلى دول أخرى …) ما حدث للسوريين على يد احتلال روسي تمرّس خلال عقدين بفنون سياسة “الأرض المحروقة”. كان بإمكانه أن يتفاعل بصدق مع معاناة السوريين، وتشردهم، ودمار بلادهم، وتحطيم بنيته التحتية، ووضع اليد على موارده. كان بالإمكان خفض منسوب المرتزقة المُحَرَكين من منطقة محتلّة إلى أخرى قيد الاحتلال كما في “سفر برلك” تاريخياً، مروراً بالشيشان، وصولاً إلى تجنيد بوتين لمقاتلين من سوريا المحتلة إلى القتال في أوكرانيا؛ ولا ندري اسم الدولة القادمة التي سيحرك فيها بوتين مرتزقة من أوكرانيا. كان بإمكان العالم ألا يصل إلى هذه الدرجة من النفاق والانحدار، ليدفع بالسوريين إلى مراجعة الروس، قائلاً إن يدهم هي العليا في سوريا؛ وذلك بعد اتفاق “كيري-لافروف”. كان بإمكانهم على الأقل تخفيف التبجح بحقوق الإنسان واحترام القانون وحرية البشر. فها نحن نشهد استنفار منظومة الأقوياء بكليتها، مستحضرة كل صورة بشعة لروسيا؛ معتبرة أن احترام حقوق الإنسان وحريته قيمة القيم، وسيادة واستقلال الدول قضايا مقدّسة!
وها هنا، نأمل أن تكون هذه “الصحوة العالمية” قد تمّت؛ ليس فقط تجاه أوكرانيا، بل تجاه سوريا أيضاً. وفي ظل وضع كهذا، أي مقاربة، أو نمط تفكير، أو تخطيط، أو فعل يمكن للسوري أن يقوم به؟ هل يندب حظه، ويشتم كل شيء، ويعود لإحباطه وسخطه؟ أم ينطلق من جديد للتواصل مع العالم “الحر” للخلاص؛ فيخطط بعقل بارد مستفيداً من الظرف القائم؛ ليبدأ مقاومته الشعبية المدعومة في وجه الاستبداد والاحتلال معاً؛ ويبدأ “الصادقون” دولياً بفتح ملفات إجرام بوتين والإجرام الأسدي، وتزويد جبهة تحرير سوريا بما يلزم سياسياً وعسكرياً للخلاص من الاستبداد والاحتلال؟! بذا يكفّر هذا العالم عن غفلته غير المبررة، أو صمته المريب تجاه مأساة السوريين على يد احتلال روسي غاشم، ومنظومة استبداد تكاد تجهز على سوريا. وبذا يكون من استنفر لحرية الإنسان، واستقلال وسيادة الأوطان متناغماً مع نفسه. وبخصوص الأعباء المادية، ليس السوريون بحاجة إلى أحد؛ فما على بنوك الدول التي تخزن مليارات نظام الاستبداد المنهوبة من سوريا إلا أن تعيدها للسوريين، دعماً لمشروعهم في تحرير بلدهم واستعادة عافيته.
“أخيراً وليس آخراً، إذا أرادت المنظومة الدولية أن توقف طموحات بوتين المريضة، وتهزمه في أوكرانيا خاصة؛ لا بد من هزيمته واقتلاعه بداية من سوريا.
————————————–
قلق أسدي من حرب أوكرانيا/ مهند الحاج علي
إن كان للحرب الأوكرانية من مفاعيل بالمنطقة، فهي في سوريا حيث الدور الأكبر لروسيا المتواجدة عسكرياً على الأراضي السورية. لكن كيف بإمكاننا رسم خريطة الأثر الأوكراني على سوريا وعلى الوجود الروسي فيها؟
أولاً، الأثر الاقتصادي سيكون بالغاً. ذاك أن مناطق النظام السوري اليوم تُعاني من التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، وهذا من شأنه أن يتضاعف نتيجة أثر الحرب الأوكرانية والعقوبات المرافقة لها في أسعار النفط، وفي تأمين الحاجات العالمية للقمح ومواد أولية أخرى. للحرب أثر الزلزال على العالم، إن كان لجهة الأمن أو الاقتصاد أو الأمن الغذائي. وسوريا هنا أكثر عُرضة من غيرها، نظراً لوجود الجيش الروسي على أراضيها، ولاعتبارها إحدى ساحات المواجهة المقبلة. التشدد في العقوبات على النظام السوري بات امتداداً لتشديد الخناق على روسيا نفسها. وفي حال فوز روسي ولو مُؤجل، في أوكرانيا، ليس بالإمكان استبعاد سوريا عن حسابات الرد الأوروبي والأميركي، سيما أن النظام نفسه في موقع ضعيف، وهو بالتالي هدف سهل، سيما في حال إزاحة إيران وحلفائها عن المشهد بعد اتفاق محتمل جداً في فيينا.
ثانياً، وفي حال تواصل الحرب والعقوبات المرافقة لها لفترة طويلة، وهذا محتمل، قد يلجأ الرئيس الروسي وأجهزته الأمنية الى استخدام سوريا في عمليات تخريب إقليمية، أو كقاعدة للتهرب من الحصار المالي الخانق عبر التهريب أو الممنوعات أو غيرها. ولمثل هذا القرار، أثمان سياسية واقتصادية. بيد أن روسيا اليوم وفي ظل هذا الضيق المرتقب، ليست في وارد المساومة مع النظام السوري، وقد يصير التعامل معه أكثر حدة واخضاعاً مع ارتفاع احتمالات استخدام العنف لتأمين ذلك. وهذا يعني كذلك تعزيز دور الميليشيات وإضعاف العائلة الحاكمة، مع عدم استبعاد اسقاط الرئيس السوري بشار الأسد نفسه من المعادلة في حال اقتضى الأمر ذلك.
ثالثاً، لحظة انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، طارت خطة عمل النظام السوري من النافذة، تلاشت وكأنها لم تكن. كان الأمل في دمشق معقوداً على إعادة سوريا الى الجامعة العربية، وتعويم النظام عربياً، في موازاة انفراجة اقتصادية مالية ولو محدودة، تأتي على حساب إيران، لجهة تقويض وجودها أو التخفيف منه. لكن هذه الخطة باتت من الماضي. مصادر عربية متقاطعة تتحدث اليوم عن تبخر فرص عودة سوريا الى الجامعة، وبالتالي انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات مع العالم العربي. بيد أن الحسابات العربية في التعاطي مع دمشق، باتت تتقاطع مع المخاوف من التعرض لعقوبات أقسى نتيجة الحصار الغربي على روسيا.
بكلام آخر، أي تقدم أو بوادر بكسر النظام الحصار المفروض عليه، من خلال علاقاته العربية، بات اليوم خارج الحسبان. بيد أن السؤال الذي يجب أن يكون مطروحاً على بساط البحث بما يتعلق بالنظام السوري، لم يعد استخدام الورقة الإيرانية، أي التخلي عن طهران وحلفائها، علاوة على رصيد روسيا وعلاقاتها الأمنية والعسكرية للتفاوض مع المحيط العربي، وإعادة النظام السوري اليه وتعويم اقتصاده مجدداً. هذا السؤال انتهى. السؤال المطروح اليوم هو كيف ستستخدم موسكو المُحاصرة رصيدها السوري؟ ذلك أننا اليوم نتعاطى مع رئيس روسي غاضب ويتخذ القرارات وفقاً لحسابات غير منطقية.
كانت المقاربة الروسية في سوريا، مبنية على منع ايران من التهور في ادخال البلاد بأسرها في حرب. اليوم نحن أمام واقع مغاير: القرار الروسي هو الأكثر تهوراً ومخاطرة، ولن يكون النظام أهم من الجيش الروسي في حسابات بوتين. ربما لهذا السبب، هناك من يُردد بأن ساكن قصر الشعب السوري اليوم أكثر قلقاً من أي يوم مضى. هو ينتظر مصيراً يجهله، وقراراً ليس بالإمكان توقعه، ولهذا فإن عليه وسائر أعضاء العائلة شدّ الأحزمة لأن هذه الرحلة قد تكون الأخيرة، وقد يصير فيها مجرد ذخيرة تُستهلك في لحظة ضيق أو غضب.
المدن
—————————
الحرب الأوكرانية تنذر بانهيار سياسة “الوضع القائم” في سوريا
انقر هنا لتحميل التقرير و للتصفح االرجاء استخدام الأسهم في الجزء السفلي من المستند
—————————-

الكل خاسر في أوكرانيا/ فراس رضوان أوغلو
لا شك أن حدث الساعة عند كل الإعلام العالمي هو الغزو الروسي لأوكرانيا التي بدأت تأثيراتها السلبية تظهر رويداً رويداً في كثير من القطاعات على الصعيد الإقليمي والعالمي، فالحرب هنا بين دولة عظمى عسكرياً واقتصادياً وهي جزء مهم في الاستقرار والتوازن والأمن العالمي ودولة أخرى تدعمها قوى عظمى، ويبدو هذا الدعم غير محدود، والآن وقد مر ما يقرب من أسبوع على الهجوم الروسي في أوكرانيا بدأت مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية لهذه الحرب، ومع ذلك فإن القوة الدافعة الرئيسية التي وضعت هذين البلدين الشقيقين اللذين يكادا أن يكونا من العرق نفسه وحتى المذهب الديني بدأت تدفع باتجاه استمرارية الحرب أكثر فأكثر.
لا يمكن فصل الماضي عن الحاضر عما يحصل في أوكرانيا حيث تحول الصراع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية إلى صراع سلافي أوراسيوي وغربي أطلنطي وفق رؤية موسكو التي تدافع عن أمنها القومي كما تقول، فمنذ انهيار جدار برلين في عام 1989 وانهيار الكتلة الشرقية وانهيار (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية) في عام 1991 انتهى معه نظام ثنائية القطب، والذي كان قائماً على الصراع الإيديولوجي الذي سيطر على نظام العلاقات الدولية لما يقرب من 50 عامًا، لكن هذه الأفكار التي اختفت منذ تسعينات القرن الماضي مازلت موجودة في موسكو، والآن بدأت تظهر وبشكل دموي، وأما أوكرانيا الباحثة عن موضع جديد لها نحو الغرب لم تفلح مساعيها وسبقتها موسكو عبر هذا الغزو لمنعها من الانضمام نحو الغرب.
اليوم يمكننا قراءة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كفكرة حرب غربية أطلسية وسلافية أوراسية بالنسبة لروسيا والمناطق النائية الروسية فمن ناحية فإن أولئك الذين يدافعون عن تعريف روسيا الغربية (أوكرانيا) والتي تعود جذور هذه الفكرة إلى القرن الثامن عشر في زمن بطرس الأكبر، ومن ناحية أخرى يمكننا رؤية الفكر المقابل لهذه الفكرة في المعنى وهنا يمكن اعتبار أن هؤلاء يعتبرون أن هذا الصراع سوف يعيد توحيد الشرق الذي يرونه.
الأيام القادمة ستظهر لنا سياسات جديدة في المنطقة فبعد فرض العقوبات على روسيا سيتجه العالم نحو الدول المصدرة للطاقة لتعويض ما يمكن تعويضه عن النفط والغاز الروسي، وإن كان صعباً نوعاً ما لكن هذه الخطوة أصبحت ضرورية ليس فقط لارتباطها بالعقوبات على روسيا بل لسحب هذه الورقة من يد روسيا وهنا سيكون دور قادم ومهم لدول الخليج العربي في السياسات العالمية وحتى تركيا وإسرائيل وقضية شرق المتوسط قد نشهد تغيرات لما يتمتع به شرق المتوسط من طاقة لم تستخرج بعد، وهل هذا سوف يؤدي إلى تصالح يوناني تركي؟ كل الملفات مفتوحة وخاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنها مفتوحة على كل الاحتمالات.
الشرق الأوسط وتركيا معنيان جداً بهذه الحرب فكثير من المصالح والمواقف السياسية قد تتغير لتغير الظروف الدولية وحتى المعاملات المالية وحتى الاستراتيجيات السياسية والأمنية قد تتغير، فخسائر هذه الحرب لن تطول روسيا وأوكرانيا بل كثير من دول المنطقة ما لم يتم إيجاد مخرج لهذه الحرب والتي شعارها الكل خاسر.
——————————–
البوتينية واليمين السوفياتي و”مكافحة النازية”/ وسام سعادة
ما يقوله فلاديمير بوتين عملياً للشعب الروسي في هذه الأيّام أنّه، وأيّاً كانَ موقف كل نفر في هذا الشعب من المغامرة الحربية الكبرى التي أدخلت القيادة السياسية والعسكرية البلاد بها، فإن طريق الرجعة بات مقطوعاً، والتعثّر في مغامرة بهذا الحجم لن يكون هزيمة للرئيس وحده أو لهذه القيادة فحسب، بل سيكون هزيمة مباشرة وشاملة لكل الروس.
لأجل ذلك، فالدعاية الروسية – على تهلهل حججها وتواضع مؤثراتها إزاء الإعلام الغربي، والتضامن العابر للقارات مع الأوكران في مواجهة الغزو المتواصل لوطنهم – إلا أنّها تركّز على هدف محدّد وتصيبه: تفسير كل ردات الفعل والمواقف والاجراءات الغربية على أنها تأكيد على أن أي انشقاق داخلي وأي تعثر للجيش في أوكرانيا سيدفع الروس ثمنه جميعاً، وبمنتهى القساوة.
في هكذا دعاية صدى لما يعتمل منذ نهاية الثمانينيات في صدور الأجيال المتعاقبة من الروس. فتفكيك الاتحاد السوفياتي كان على يدهم، لم يغصبهم الأمريكيون عليه. هم الروس الذين ما عادوا مقتنعين بالشيوعية. ومع ذلك عوقبوا على ذلك وعوملوا كمهزومين.
طبعاً، من الزاوية الأمريكية والغربية لا يُعقل عدم تمييز رابح من مهزوم في نهاية الحرب الباردة. أما عند الروس فالمسألة تختلف. فمن ناحية، اسقاط الاتحاد السوفياتي كان على يدهم وروسيا الاتحادية هي من أعلن استقلاله عن الاتحاد السوفياتي بعد أن كانت كبرى جمهورياته. لكن من ناحية ثانية ثمة قناعة يتشاركها قسم كبير منهم، وعبّر عنها بوتين بوضوح، وهي تعتبر زوال الاتحاد “كارثة جيوبوليتيكية” لروسيا. ليس فقط لأن زواله جلب اختلالاً فظيعاً في الميزان العالمي للقوى بل لأن تحويل الحدود التي كانت قائمة بين جمهوريات الاتحاد الى حدود دولية بين البلدان وبشكل آليّ لا يمكن أن يسمح للجمهوريات السابقة بممارسة سيادتها كاملة إلا على حساب روسيا الإتحادية ويأكل من رصيد الروس الإثنيين واللغويين.
يتصل ذلك بهذا العنوان الغريب المعطى لعملية غزو وتفكيك أوكرانيا: محاربة النازيين.. في العام 2022!!
فهناك من ناحية من يضيء على حيثيات يُفسَّر بها كلام بوتين، ليس أقلها تعاون القوميين الأوكران مع الإحتلال الألماني إبان أعوام الحرب، وانتماء قسم أساسي من المعادين لروسيا والروسنة في أوكرانيا الى هذه المدرسة، مدرسة ستيبان بانديرا التي تمكنت الاستخبارات السوفياتية من تصفيته في ميونيخ خريف 1959 بعد أربعة عشر عاماً على اندحار النازية، وهي أعوام تواصل فيها الصراع بين السوفيات وبين “منظمة القوميين الأوكران” في غرب أوكرانيا. يأتي بعد ذلك النظر في مصائر هذه الفاشية الأوكرانية وما هي نسبتها من مجموع القوى في أوكرانيا اليوم، وما هي نسبتها لليمين المتطرف الروسي الشبيه بها في الكثير أيضاً.
هناك في المقابل، من يستهجن كيف يمكن اتهام بلد رئيسه يهودي بأنه مؤيد للنازية. هذا مع أن المعسكر المؤيد للغرب في كييف استطاع منذ 2004 الجمع بين رد الاعتبار الى شخصيات مرتبط اسمها بسفك دماء اليهود مثل سيمون بتليورا وستيبان بانديرا، وبين “محاباة السامية” عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وهذه الازدواجية غير محصورة بأوكرانيا. يمكن لحظها أيضا في معشر ورثة “الاوستاشا” القومية المرتبطة بالاحتلال النازي وباضطهاد اليهود في كرواتيا. ما يقوله القوميون الأوكران أن فظائع أسلافهم ضد اليهود كانت بسبب احتسابهم اليهود على الدولة الشيوعية، واحتسابها كدولة على اليهود، وأن الأمر تبدّل بعد ذلك، وانفكّ اليهود عن هذه الدولة، وغدوا يبتغون الهجرة الى الغرب وإسرائيل فلم يعد ثمة أساس عميق للمشكلة معهم!
أي أن اليهودي الذي حاربوه هو اليهودي الذي كان يذكرهم بالبلاشفة. واليهودي الذي يحبونه هو الذي يذكرهم بإسرائيل وبخاصة بالجناح التنقيحي من الحركة الصهيونية، الذي تأسس في أوديسا نفسها على يد فلاديمير(زئيف) جابوتنسكي مطلع القرن الماضي، مع بناء ميليشيا الدفاع الذاتي اليهودي في المدينة بعد مذبحة كيشينيف (عاصمة مولدافيا اليوم) ضد اليهود، وقد استوحى القوميون الأوكران من هكذا تجارب على تماس جغرافي معهم، وليس فقط من التجربة الفاشية والنازية. بل إن الصلات بين جابوتنسكي والقوميين الأوكران حتى في مرحلتهم اللاسامية الحادة لم تنقطع.
بيد أن موال مكافحة النازية الذي يستجلب على بوتين الهزء والاشمئزاز خارج روسيا، كونه قبل كل شيء سيخسر مباشرة المعركة الميديائية تجاه نظام يتهمه بالنازية ورئيسه المنتخب يهودي، هو في الوقت نفسه شيفرة قومية روسية وظيفية: الفكرة من ورائها أن الروس الإثنيين هم الذين دفعوا الضريبة الكبرى لدحر النازية، وأن أي محاصرة لهم أو تطويق هو شكل من أشكال إعادة تأهيل مشاريع المانيا الهتلرية تجاه الشرق.
بالتالي، الدعاية الروسية حول ضرب انبعاث النازية في أوكرانيا لا تنحصر في “كشف أصول” القوميين الأوكران، إنما الأساس فيها هو أن الروس الإثنيين هم الذين قدّموا أوسع التضحيات وأعلى البطولات ضد ألمانيا النازية، وكل محاولة لإضعافهم هي شكل من أشكال النازية.
هكذا دعاية ليست تتمحور حول إبادة اليهود كي يكون الرئيس اليهودي لأوكرانيا بمثابة ضربة قاضية لها على المستوى العاطفي الروسي، وان كانت زيلينسكي حجة كافية لإبطال الدعاية خارجياً.
الخطاب الروسي منذ عقود طويلة مبني على أن الروس ضحوا بخمسة أو ستة أضعاف عدد من قضى من اليهود، وأنهم الأولى بالمظلومية كما بنسب الانتصار لهم من سواهم، وأن الاتحاد السوفياتي بسبب من طبيعته الأممية ظلم الروس الإثنيين ولم يعط لهم القدر المستحق والواضح في السردية الرسمية عن الحرب الوطنية العظمى، بل سوّاهم بالقوميات الأخرى (إلا تلك التي اعتبرت رسميا غير وطنية وعميلة وجرى ترحيلها) باستثناء النَخَب الذي تقصّد جوزيف ستالين رفعه بوضوح للروس الإثنيين عند النصر.
بالنسبة إلى الخطاب القومي الروسي، الروس الإثنيون هم الضحية القصوى للنازية وليس اليهود. ولأجل ذلك أيضا يمكن لهذا الخطاب أن يمزج بين رؤية النازية في كل مكان، وبين احتضان النزعات اللاسامية.
هذا المزج بين تمغيط مقولة مكافحة النازية وبين النزعة اللاسامية في روسيا اليوم يقوم على مفارقة اتهام اليهود في الوقت نفسه بأنهم جلبوا الثورة الشيوعية لروسيا وبأنهم ساهموا في تخريب الاتحاد السوفياتي. وفي هذا محاكاة للكيفية التي يجمع بها بوتين بين الحنين للاتحاد السوفياتي وبين النقمة على لينين. وهذه عند الروس عصارة تيار له باع طويل.
فبعد الحرب الأهلية الروسية، انقسم الخاسرون من “البيض” فيما بينهم في المنافي الأوروبية.
قسم اعتبر أن الدولة السوفياتية هي نقيض لكل التاريخ الروسي. ولأجل ذلك راح هذا القسم بعيدا في اللاسامية. فاعتبر أن الدولة السوفياتية هي دولة سيطرة اليهود على روسيا من خلال الشيوعية.
لكن قسماً راح في الاتجاه المعاكس تماماً. اعتبر أن الثورة كانت كارثة (تفسّر أيضاً بتهمة لاسامية ضمنية أو واضحة لليهود)، لكن الدولة التي نتجت عن الثورة يسجّل لها أنها استطاعت ايقاف الثورة، ومن ثم استطاعت استئناف التاريخ الامبراطوري الروسي، وبالتالي الامبراطورية الروسية المنقطعة مع لينين عادت واستأنفت وجودها مع ستالين.
قسم من هؤلاء المهاجرين قال ذلك في المنفى، وقسم منهم عاد. بعض العائدين جرى التنكيل به لاحقاً. البعض الآخر انضوى تحت عباءة الدولة والحزب. شكّل ما يمكن وصفه اليمين السوفياتي.
هذا اليمين السوفياتي المتعدد المشارب لم يكن مقتنعاً بسردية الثورة، لكنه كان مقتنعاً بملحمة إعادة بناء الدولة الامبراطورية بنتيجة الثورة، ولأجل ذلك اعتبر أن الحرب الوطنية العظمى هي الثورة الحقيقية وليس ثورة اكتوبر، لكنه أخذ على الدولة في الوقت نفسه أنها لم تسجّل النصر بشكل أساسي للروس الإثنيين، للروس الكبار.
البوتينية تنتمي إلى هذا الجذر.
القدس العربي
——————————
الانحياز للغرب في اوكرانيا..كواجبٍ مؤقت/ ساطع نور الدين
الوقوف مع الغرب، ولو من دون دعوة، في حربه الأوكرانية مع روسيا، جذابٌ ومؤنس، ومحقٌ طبعاً لاعتبارات سياسية واخلاقية وانسانية لا جدال فيها. لكنه ليس مجدياً، لأنه لا يزيل حواجز عدم الثقة، ولن يخدم أي قضية خارج المجال الاوروبي، ولن يسهم في مزاعم الاندماج في الثقافة الغربية.. التي تتطلب هي نفسها، الحوار والانتقاد، بل تسمح بإعلان الحياد، بقدر ما تنادي بالانخراط في الحرب.
التواضع شرط ضروري للمضي في الدفاع عن هذا “الانحياز” لطرف كانت معاداته ومخاصمته من الاسس الصلبة لثقافة العالم الثالث كله، وليس فقط العالم العربي او الاسلامي. وكذا الامر بالنسبة الى روسيا التي كانت حتى الامس القريب حليف العرب وشريكهم في حروبهم، قبل ان تصبح عدو شعوبهم الراغبة بالحرية والديموقراطية، كما كانت خصم الشعب الاوكراني وثورته البرتقالية، وقبل ان تتوج على رأس الدول المدافعة عن أنظمة الاستبداد والفساد العربيين.
أما بالنسبة الى اوروبا، وهي أقرب الى العرب والمسلمين من روسيا، في الجغرافيا وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الثقافة طبعا، فإن الوقوف معها يكاد يرقى الى مستوى الواجب، حتى ولو لم تسترد القارة العجوز قيادة الحرب مع روسيا من الاميركيين، الذين يمكن أن ينزعوا عن تلك الحرب أهدافها الانسانية”النبيلة”الخاصة بحماية الشعب الاوكراني وحقه بالحرية والاستقلال والديموقراطية، ويدرجونها في سياق حروبهم المقبلة مع الصين في وقت لاحق من القرن الحالي.
وليس من قبيل المجازفة القول ان الانحياز في الحرب الاوكرانية الى جانب الطرف الضعيف، مؤقت، لأن موازين القوى يمكن ان تنقلب رأساً على عقب، إذا ما تبين فعلا بأن الجيش الروسي ليس بالقوة التي تروج عنه، (عدا اسلحته النووية)، وإذا ما انتصرت المقاومة الاوكرانية، او على الاقل تمكنت من تحويل بلادها الى افغانستان ثانية..بدعم عسكري وسياسي غير مسبوق من حلف شمال الاطلسي.
لكن، ومهما كان المدى الزمني المفترض للانحياز الحالي، فان التواضع يستدعي الاقرار أيضاً بانه لن يغير شيئاً من موازين القوى، ولن يؤثر في مواقف المتحاربين الكبار. وعليه يصبح الموقف، الرسمي والشعبي، مجرد رأي أو إنطباع أو تعبير متداول في الفضاء، تسمح به حقوق النشر الخاصة بوقائع الحرب الاوكرانية الطاحنة، وحقوق المشاهدة المتاحة بالمجان للملايين من سكان العالم، الذين يتسمون هذه الايام امام شاشات التلفزيون او الكومبيوتر او التلفون.
في صور الحرب الاوكرانية وتفاصيلها، الكثير مما يمكن ان يقال عن أوجه شبه واختلاف مع حروب الشوارع في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا..لكنه لا يساعد في فهم الموقف الروسي ولا في تفسير الموقف الاوروبي ولا في تفهم الموقف الاميركي. المدنيون الاوكرانيون الذين يتساقطون اليوم، او الذين يفرون من بلدهم، هم الاصل وهم المعيار الاهم للحكم على الحرب والمبرر الاقوى للانحياز الى جانب أولئك الضحايا الابرياء.
يضاف الى ذلك مبرر حاسم، هو ان روسيا التي تحولت الى دولة خطرة يمتد تهديدها الى العالم العربي، بقدر ما يستهدف محيطها الاوروبي المباشر، قدمت مثالاً فظاً على أنها أصبحت دولة قاهرة، عندما قررت أن تطيل عمر النظام السوري وتمدد بالتالي عمر الحرب السورية وعذابات السوريين المقيمين والمهجرين، وتستخدم لذلك قوة عسكرية تكاد توازي تلك التي تستخدمها ضد الشعب الاوكراني، وتجعل الحملة العسكرية الروسية على سوريا المستمرة منذ سبع سنوات، تبدو أشبه بمناورة بالذخيرة الحية مهدت للحرب الحالية ضد أوكرانيا.
هذا النموذج للسلوك الروسي المدمّر في سوريا، الذي واكبته تجارب مماثلة في مصر والعراق وليبيا..يقوي حجة الوقوف مع الغرب، ودعوى الالتحاق ب”الأخيار”، ولو بشكل مؤقت، وعابر، وحتى من دون تلقي أي طلبٍ أو أي إذنٍ غربي.
المدن
——————————-
عن روسيا وانتحالها شخصية الاتحاد السوفييتي/ عائشة البصري
كباقي الأسر، تحتفظ أسرة الأمم المتحدة بأسرارها، وتتستّر عن أكثرها إحراجا، تلك التي تُفْضَح، من حين إلى آخر، حين يقتتل أفراد العائلة الواحدة، كما هو شأن روسيا وأوكرانيا اليوم. في خضمّ مقاومتهم الغزو الروسي بلادهم، يشنّ الدبلوماسيون الأوكرانيون في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحافل دولية أخرى حملة مكثّفة من أجل طرد روسيا من مجلس الأمن، زاعمين أن عضويتها الأممية غير شرعية، لأنها لم تخضع للإجراءات الضرورية للانضمام إلى الأمم المتحدة بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي. اتّهام أوكرانيا بالغ الخطورة، لاستناده إلى حقائق تاريخية تُظهر انتقائية تطبيق المنظمة الدولية قوانينها، وازدواجية معاييرها.
عند تأسيس الأمم المتحدة في خريف 1945، كان الاتحاد السوفييتي يتكون من 15 جمهورية اشتراكية، وأبدى زعيمه، جوزيف ستالين، تخوّفا من هيمنة الدول الغربية على صنع القرار في المنظمة. لتبديد مخاوفه، وافقت القوى العظمى، وفي مقدمتها أميركا وبريطانيا، على منح العضوية الكاملة لجمهوريتين من الاتحاد السوفييتي ذاته، أوكرانيا وبيلاروس تحديدا. وبهذه الخطوة السياسية، العبثية قانونيا، أصبح الاتحاد السوفييتي يتمتع بتصويت ثلاثي في الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى.
جرت الرّياح بما لم يشتهه ستالين، وانهار الاتحاد السوفييتي، لكن روسيا، أكبر جمهورياته وأقواها، عزمت على أن ترث عضويته في الأمم المتحدة، بغض النظر عن قانون المنظّمة. تأسّس كومنولث الدول المستقلة الذي ضمّ 12 من جمهوريات سوفييتية سابقة، بما فيها أوكرانيا وروسيا، وأُعلن، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1991، أنه لم يعد للاتحاد السوفييتي وجود، باعتباره موضوعا للقانون الدولي والواقع الجيوسياسي. وبعد أن قرأت دول الكومنولث الفاتحة على روح الاتحاد، قرّرت مدّ طوق النجاة لروسيا، ومنحته عضوية الاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة، بما في ذلك المقعد الدائم في مجلس الأمن.
قبل استقالة آخر رئيس سوفييتي، ميخائيل غورباتشوف بيوم، أي 24 ديسمبر/ كانون الأول من السنة نفسها، نقل السفير السوفييتي، يولي فورونتسوف، إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، خافيير بيريز دي كوييار، رسالة من أوّل رئيس للاتحاد الروسي، بوريس يلتسين، يخبره فيها إن دولته، بدعم دول الكومنولث، تواصل عضوية الاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة، وتتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع حقوق الاتحاد السوفييتي والتزاماته بموجب ميثاق المنظمة. واختتم مراسلته بطلب استبدال اسم “اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية” في المنظمة بـ”الاتحاد الروسي”.
لم تُبدِ أية دولة اعتراضها، على الرغم من الجدل الذي أثاره آنذاك بعض السياسيين والخبراء القانونيين، وفي مقدمتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى حدود 1984، المحامي يهودا تسفي بلوم الذي حاجج بأن عضوية الاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة قد سقطت بسقوطه، لارتباطها بكيان قانوني اختفى تلقائيا بفعل تفكيك الهياكل القانونية للاتّحاد. وجادل بأنه كان في وسع روسيا الاحتفاظ بعضوية الاتحاد، “الدولة الأم”، لو أن الجمهوريات الـ 15، باستثناء روسيا، قد أعلنت جميعها الانفصال عن الاتحاد، لتظلّ روسيا محتفظة بهويته وكيانه القانوني، حتى وإن غيّرت اسمها.
يستند يهودا إلى مبادئ قانونية دولية، أقرّتها بدورها اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول لسنة 1947، بشأن سابقة انفصال باكستان عن الهند. وأكّدت اللجنة القانونية الأممية أن الكيان المنفصِل عن دولة عضو في الأمم المتحدة هو الذي عليه التقدّم إلى المنظمة بطلب عضوية جديدة، في حين أن الدولة التي خَضَعت للانفصال، أو لتغيير في حدودها أو دستورها، تحتفظ بالشخصية القانونية للدّولة ذاتها. وأوضحت اللّجنة أنه حين تزول هذه الشخصية، وتتأسّس دولة جديدة، فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح لها بالتمتّع بعضوية في المنظمة، إلا إذا جرى قبولها بشكل رسمي.
هذه هي قاعدة تعاقب الدول (Succession of States) التي طبقتها الأمم المتحدة عند انفصال باكستان عن الهند، وبنغلاديش عن باكستان وغيرها من الحالات، وانتهكتها في الحالة الروسية، لتسمح لموسكو بانتحال الشّخصية الدّولية للاتحاد السوفييتي. ولأن القانون الدولي غالبا ما يخضع للسياسة في العلاقات الدولية التي تحكم المنظمات الدولية، فقد وافقت واشنطن وباقي الأعضاء الدائمين على خرق قوانين الأمم المتحدة. ويعود ذلك إلى التقاء مصالحهم بشأن نقطة أساسية، لخّصها قرار وزارة الخارجية الأميركية آنذاك، مفادها بأنّ مواصلة روسيا عضوية الاتّحاد السوفييتي تخدم أكثر مصلحة البلاد في الحفاظ على الحقوق والالتزامات القانونية والاتفاقات التعاهدية المبرمة معه في السابق.
وبعد أن فُحص الموضوع من كل جوانبه، أعلن الرئيس الأميركي، جورج بوش الأب، في ليلة عيد الميلاد للعام 1991، أن بلاده تدعم جلوس روسيا في مقعد الاتحاد السوفييتي في مجلس الأمن. هكذا طُوي الموضوع الذي لم يُطرح أصلا للنقاش في أجندة المنظمة. اليوم، وبعد أزيد من ثلاثة عقود على هذه الواقعة، تُقلّب أوكرانيا أوجاع روسيا لتجعلها تدفع ثمنا باهظا لعدوانها. ونظرا إلى ضغوط التحالف الأورو- أميركي داخل المنظمة الأممية، بإمكانه حشد الدعم الكافي لكي تقوم الجمعية العامة بتعليق عضوية روسيا في “مجلس حقوق الإنسان”، بموجب قرارها رقم 60/251، إن توفرت أغلبيـة ثلثي أعضائها، مثلما علّقت الجمعية عضوية ليبيا في المجلس ذاته في مارس/ آذار 2011 وأعادتها إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها.
أمّا طرد روسيا من الأمم المتحدة، أي من أجهزتها الرئيسية الستة، بما فيها مجلس الأمن، فهذا غير واردٍ، لحرص كلّ من واشنطن وباريس ولندن وبكين على الحفاظ على اتفاقاتهم ومعاهداتهم مع موسكو. ويبدو الأمر شبه مستحيل أيضا في ظل الفيتو الصيني الذي ينبغي إزاحته لطردها بعد تعديل ميثاق المنظمة. وفي حال قرّر التنين الصيني سحب البساط من تحت قدمي الدبّ الروسي، وهو أمرٌ جدّ مستبعد حاليا، واتفق الأربعة الكبار على شطب اسم “اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية” من المادة 23 من الميثاق، فإن إبقاء هذا المقعد شاغرا سيشعل حربا دولية حوله، وسيفتح عليهم باب جهنّم إصلاح هيكل المجلس، بين مطالب الدول التي تودّ توسيع عضويته، وأخرى تريد اختزال مقعدي فرنسا وبريطانيا في مقعد واحد يُمنح للاتحاد الأوروبي، وأخرى تطالب بالتخلي عن دكتاتورية “الفيتو”، وغيرها من مطالب لا تروق للأعضاء الدائمين. الميثاق هو صندوق باندورا الذي يحرصون على عدم فتحه، حتى لا تنفلت منه كل الشرور، أو بعضها.
في هذا السياق السياسي المتأزّم، يبدو سعي الدبلوماسيين الأوكرانيين إلى طرد روسيا من مجلس الأمن وكأنهم يركضون وراء السّراب. وحتى لا يحلم الأوكرانيون أكثر، لم يتأخر ردّ الأمم المتحدة عبر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، الذي ذكّرهم أخيرا، في مؤتمر صحفي، بحُكم الأمر الواقع في المنظّمة: “من الواضح للجميع من له (الاتحاد الروسي) مقعد في مجلس الأمن، وهذا هو الواقع”.
العربي الجديد
————————-

نهاية الرخاء: البوتينية تجرّ أوروبا إلى حروب هوامش العالم/ محمد أبي سمرا
تبدو حرب روسيا البوتينية على جارتها العزيزة على قلب القيصر الروسي الجديد ووجدانه ولغته وأفعاله السلطانية، وكأنها أيقظت قلب العالم، فجأة، من سبات سلامِهِ ورخائه واستقراره، لتقول له إن الحرب التي أزاحها إلى أطرافه أو هوامشه، وعدّها من ماضيه الكريه البعيد، لا تزال كامنةً في مركزه، وتتحكم بتاريخه وحاضره ومستقبله، وليست من النوافل والسواقط. بل هي التاريخ والجغرافيا والسياسة. أما اقتصاد الأسواق التجارية والمالية المفتوحة والمتنافسة، والتبادل الحر والمصالح المتبادلة والشرِكات والشراكات عابرة الحدود والاستهلاك، المعولمة كلها -وهي صارت محور السياسة الأساسي، وهمّشت الانفاق العسكري والتسلح والحرب- فبدا أنها صارت مسرحًا للحرب أو تتهيأ للحرب.
هذا فيما الحروب التي أُزيحت إلى هوامش العالم بعيدًا عن قلبه ومركزه، ليست كثيرة ولا قريبة زمنًا فحسب. بل لا تزال حيّة راعفة، وتتناسلُ نازفةً ومدمّرة، وتنتشر عدواها في أرجاء غير قليلة من العالم. لكن قلب العالم حاول ويحاول نسيانها أو تناسيها، ما دامت تعسُّ بعيدًا على أطرافه، كحرائق في ديار شعوب وأقوام، طوائف وجماعات، تقتتل وتتذابح مدفوعة بعجزها المديد عن إنجاز معجزة العصر الحديث: الدولة-الأمة القومية أو الوطنية التي عاشت نماذجها المؤسِّسة حروبًا عاصفة مدمّرة، قبل أن تعزف شعوبها وأقوامها المقتتلة عن التقاتل، وتدخل إلى جنة وئام العالم المعاصر وسلامه وفسيح تاريخه غير الحربي ولا المجنون. ولتصير الشعوب التي لم تدخل إلى تلك الجنة (الدولة) على هوامش العالم، ومن سواقطه وسواقط تاريخه، بعدما استعصى عليها أن تصير دولًا، وسمّيت دولًا فاشلة، استرسل أهلها في اقتصاد ريعي استهلاكي فقير، وتراكم ثرواته نخب مغلقة ومارقة.
وقد يكون الأشهر والأبرز حضورًا في الذاكرة من هذه الهوامش السواقط التي تعسُّ فيها حروب سمِّيت هجينة: أفغانستان، العراق، ليبيا، اليمن، سوريا، وجارها الصغير لبنان الذي تعزّه سوريا الأسد معزّة روسيا البوتينية لجارتها أوكرانيا.
وربما كان لبنان أول من افتتح أو افتُتحت فيه الحروب الهجينة المنسيّة في سبعينات القرن العشرين السعيدة مع ستيناته الأسعد. وقد تُرِكت تلك الحرب تعسُّ وتتناسل دهرًا في لبنان (1975–1990)، حتى ذهبت أخيرًا، مثالًا أو نموذجًا عالميًا أو دوليًا ساطعًا على الحروب الهامشية الهجينة، فصار يقال “اللبننة” عن كل حرب أهلية، إقليمية ودولية بالوكالة، هُمِّشت وصارت من المنسيات والمهملات.
لكن ها هو قلب العالم، بل العالم كله، يستفيق من سباته على نفير الحرب البوتينية على أوكرانيا، ليكتشف أن الحرب الغاشمة هي التاريخ. وأن السلام في قلبه ومركزه ليس أكثر من سحابة صيف عابرة وسعيدة. وأن غضَّ الطرف عن تدمير الشيشان وغروزني، وعن جورجيا وأبخازيا وشبه جزيرة القرم وأوكرانيا قبل الحرب البوتينية الأخيرة عليها، وعن لبنان وسوريا واليمن والعراق، وتلزيمهما لحرس إيران الثوري بعد يأس دول قلب العالم من حروبها فيها، ليس سوى تنصّل موقت من التاريخ الدامي الأليم.
وربما وحده وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، تنبّه -أثناء الزحف العسكري الروسي البوتيني على بلده وتدمير مدنه- إلى ما تُرك لبوتين أن يفعله في سوريا، فقال: يجب على العالم ألاّ يتركه يفعل ذلك في أوكرانيا الأوروبية. وربما هو ما كان ليتذكر سوريا ويذكرها، لولا الزحف البوتيني على بلده ليجعل عاصمته كييف مثل حلب وحمص. والوزير الأوكراني تذكّر ذلك وقاله واقفًا في العراء والصقيع إلى جانب وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن، على الحدود الأوكرانية- البولندية، فيما الأوكرانيون يفرون من بلدهم إلى ديار السلام والأمن الأوروبية.
ووقف الوزيران تلك الوقفة قبل أن يأويا إلى خيمة نُصبت على حدود دول الناتو الأوروبية. وهي تذكّر بخيمة مماثلة نُصبتْ سنة 1958 على الحدود السورية- اللبنانية ليأوي إليها رئيس الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) جمال عبدالناصر، والرئيس اللبناني الجديد آنذاك فؤاد شهاب. وذلك بعد واحدةٍ من تلك الحروب الأهلية الهجينة الصغيرة والعابرة في لبنان. وهي كانت حربًا محلية، أدت تشابكاتها الإقليمية والدولية التي بعثتها إلى نزول فرقة من جيش البحرية الأميركية على شاطئ بيروت. فآنذاك كانت الحرب العالمية الباردة لا تزال في ذروتها، قبل أن ينصرف قلب العالم أو مركزه إلى إحلال الاقتصاد التبادلي والتنافسي المعولم قطبًا راجحًا في مساره، محل سياسة القوة العسكرية والحرب.
وأيقظت البوتينية الروسية اليوم سياسة القوة والحرب في أوروبا، مستفيدة من الاقتصاد المعولم ورخاء قلب العالم، وغضّه الطرف عنها ومساومتها في شرق أوروبا الأقصى أو أوراسيا، وفي سوريا التي جعلتها مختبرًا تجريبيًا لفاعلية أسلحتها الحربية الجديدة التي صنّعتها وحدّثتها بفائض ما جنته من صلاتها الاقتصادية بالعالم، وتحديدًا بأوروبا التي تمدّها بالغاز والنفط الروسيّين. هذا فيما أقلعت أوروبا عن التصنيع العسكري وتحديث جيوشها، وانصرفت إلى الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي، طاردة الخوف والرعب من قلبها، بعد زوال الستار الحديدي السوفياتي.
وفيما كان الجيش الروسي البوتيني يزحف على أوكرانيا، هبَّ بعض الروس المتأوربين ربما، إلى المطالبة بوقف ذاك الزحف الحربي، فاعتقلت السلطات البوتينية ولا تزال تعتقل منهم الألوف. وأصدر الكرملين بيانًا قال فيه: ليس الآن وقت الشِّقاق والانقسام. الآن وقت وقوف روسيا صفًا واحدًا خلف قائدها بوتين. وياما اختبرت هوامش العالم مثل هذه الرطانة، في سوريا ولبنان الأسد، وفي عراق صدام حسين، وليبيا معمر القذافي، وإيران الجمهورية الإسلامية.
وها هو الجيش الروسي يزحف غربًا، فيحاصر مدن أوكرانيا ويُعمِل فيها الحديد والنار، كي تقف خلفه صفًا واحدًا، بعدما استأنس بوتين بما فعله بمدن سوريا التي تذكّرها الوزير الأوكراني واقفًا في العراء على حدود بلاده.
وها هي البوتينية الروسية تُرغم ألمانيا على تخصيص مئة مليار دولار للتسلُّح وتحديث جيشها، بعدما حرّمت على نفسها الإنفاق العسكري عقب مآسيها في حربين عالميتين. وها أوروبا تَعِد نفسها باستضافة ملايين الأوكرانيين الهاربين من الرعب والدمار البوتينيّين الزاحفين على بلدهم ومدنهم. فهل حان موعد أوروبا مع وداعها رخائها الاقتصادي واستقرارها السياسي؟ وهل الحرب هي كل التاريخ والجغرافيا والسياسة؟
المدن
——————————-
الرجل الذي فاجأ بوتين/ غسان شربل
الصدفة التي استدعت فولوديمير زيلينسكي إلى منعطف كبير فعلت ذلك من قبل. بعد الاستدعاء تتوقف القصة على براعة الرجل وإرادته كي يصنع صورته وقصته. وأحياناً يرفع رجل أعزل سبابته في وجه إمبراطورية فيحرجها ويؤلمها ويذهب معها إلى التاريخ. ويمكن أن يسقط الرجل في الامتحان إذا اختار أسهل السبل وهي الانحناء أو السلامة والابتعاد. ويحدث أن يلتقط اللحظة كالصياد الماهر فيسدد في الوقت الملائم فيربح حتى لو هُزم أو تمكنت الطريدة من الإفلات.
ذات يوم كنت أحاور حازم جواد، الرجل الذي قاد «البعث» العراقي إلى السلطة في 1963. سألني إن كنت أعرف أن كل هالة صدام حسين بدأت بمحض الصدفة. ولأنني لم أكن أعرف روى لي. قال إن نواة من قيادة الحزب بزعامة فؤاد الركابي قررت في عام 1959 اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم. تم اختيار الفريق المكلف بالتنفيذ والمكان. قبل وقت قصير من الموعد المحدد قرر أحد أعضاء الفريق عدم المشاركة. ولملء الفراغ رشح أحد المشاركين شاباً هادئاً صلباً وقليل الكلام، اسمه صدام حسين. سارع صدام وشارك وأصيب. فر بعد المحاولة الفاشلة إلى وكر حزبي. وتقول الحكايات إنه استخدم شفرة لنزع الرصاصة من ساقه. ونجح بعد ذلك في المغادرة إلى سوريا، ومنها إلى مصر. مجرد مصادفة. لكن الحادث أعطى صدام صورة وشرعية في الحزب، استخدمهما لاحقاً في صعوده.
حين ولد زيلينسكي في العام 1978، كان شاباً في السادسة والعشرين اسمه فلاديمير بوتين يستكمل في الردهات الغامضة لعالم الـ«كي جي بي» تدريباته على العيش باسم مستعار والكتابة بالحبر السري وإتقان التضليل والبراعة في الإفلات من المطاردين. وأغلب الظن أن الشاب السوفياتي لم يكن يحلم بأكثر من ترقيات في الجهاز الذي كان مكلفاً سرقة أسرار الغرب وتجنيد الجواسيس أو اكتشافهم. ولم يدرِ في خلد الشاب أن الإمبراطورية العظيمة ستتفكك وأن الجمهوريات التي كانت محشورة في القفص السوفياتي ستسارع إلى تبديل قواميسها وثيابها وستبوح بحبها للغرب. وحين قفزت أوكرانيا من القطار السوفياتي كان زيلينسكي صبياً في الثالثة عشرة يحب تقليد الممثلين وإضحاك أقرانه. وفي تلك الأيام، استدعت الصدفة أنجيلا ميركل لتشق طريقها إلى مقر المستشارية بعدما ألقت ألمانيا الشرقية بنفسها في حضن الوطن الأم.
شهد بوتين من دريسدن انهيار جدار برلين. كان انخرط في العمود الفقري للنظام الذي دهمته الشيخوخة في الثمانينات بعد إقامة ليونيد بريجنيف الطويلة وتعاقب الجنازات في الكرملين.
لم يفعل زيلينسكي شيئاً من هذا. أحب التمثيل. وأغراه دور المهرج. ولم يشعر مرة أن التاريخ يهم باستدعائه وأن عليه الاستعداد للقيادة عند المنعطفات.
لم يكن هناك ما يدفع إلى الاعتقاد أن القدر سيستدعي الرجلين إلى مبارزة على حلبة دامية. مبارزة لا تمس نتائجها فقط صورة الرجلين وبلديهما، بل أمن العالم وتوازناته واقتصاده. ففي بدايات القرن كان بوتين منهمكاً بتضميد جروح «الروح الروسية» وترميم هيبة «الجيش الأحمر» وترويض المقاطعات وبارونات الانهيار الكبير. وفي تلك الأيام أسس زيلينسكي فريقاً ناجحاً للإنتاج التلفزيوني أسماه «كفارتال 95». وحين كان سيد الكرملين يغذي سراً حلمه بالثأر ممن دفعوا جدار برلين وإمبراطورية لينين إلى الهاوية، كان زيلينسكي منهمكاً بتدبيج مضامين ترفيهية ناجحة لمسلسلات تلفزيونية اجتماعية ساخرة ومسلية. ولما راح بوتين يلاعب قادة الغرب ويسخر من تساقطهم بفعل ضجر الديمقراطيات من رجالها ووطأة وسائل التواصل الاجتماعي، كان زيلينسكي لا يحلم بأكثر من الانتقال من المسرح إلى الشاشة. حتى حين تزايد اقتناع بوتين أن روح الأمة استدعته وكلفته مهمة تاريخية مقدسة، كان زيلينسكي منهمكاً برفع نسبة المشاهدين.
عندما استرجع بوتين شبه جزيرة القرم في 2014، لم يكن العالم يعرف شيئاً عن زيلينسكي، ولم يكن مضطراً. وحين أنزل سيد الكرملين في السنة التالية قواته في سوريا، كان الممثل الأوكراني يأسر المشاهدين بدوره في الموسم الأول من مسلسل «خادم الشعب». في المسلسل، جسّد زيلينسكي دور مدرس تاريخ بسيط تسلق السلم الاجتماعي تدريجياً حتى صار رئيساً للجمهورية بعد استخدام كلمات نابية ضد الفساد. وفي 2018 وبعد نجاح المسلسل، قرر زيلينسكي الانخراط في السياسة. وفي السنة التالية حملته الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى قصر الرئاسة. واللافت أن السيد الرئيس بذل جهداً لتحسين لغته الأوكرانية، ذلك أنه ولد في منطقة أوكرانية يتحدث معظم سكانها الروسية.
لم يكن الانضمام إلى حلف «الناتو» مشروعاً ملحاً بالنسبة إلى الرئيس الذي قال إن الخطوة يجب أن يسبقها استفتاء. وكان من الصعب عليه معالجة الجروح الانفصالية في الخريطة، لأن طريق الحل تمر في موسكو.
الصدفة التي دفعت زيلينسكي إلى قصر الرئاسة أوقعته في منعطف شديد الخطورة. كان معظم العواصم تعتقد أن مناورات الجيش الروسي لن تتعدى التخويف لانتزاع تنازلات. ولم يصدق كثيرون ما راحت واشنطن تردده عن «الغزو الوشيك» مرفقاً بالمواعيد. لكن القيصر فعلها، وأوقع نفسه وبلاده والعالم في أكثر الأزمات تعقيداً بعد الحرب العالمية الثانية.
بعد انطلاق الهجوم الروسي كان باستطاعة رجل واحد إنقاذ أوروبا والعالم من عودة أشباح الحرب العالمية الثانية. كان باستطاعته إنقاذ القيصر وصورته وبلاده. كان زيلينسكي يحتاج إلى استيلاء الخوف على روحه وجسده ليسلم بشروط موسكو، أو أن يغادر ليترك لرجل آخر مهمة توقيع ما يشبه الاستسلام. وربما كان يمكن أن ينقذ القيصر لو قُتل في الطلقات الأولى وقفز الجيش لتطبيق الحل الروسي كما اشتهى بوتين. لم يفعل. فاجأ مواطنيه وفاجأ العالم. بالقميص الزيتوني أطل. قال للزعماء الغربيين المتصلين إنه يحتاج «إلى ذخائر، لا إلى بطاقة سفر». سخر الرئيس اليهودي من حديث بوتين عن مطاردة النازيين. أحرج البيت الأبيض وكل زعماء الغرب. أوقع صورة بوتين في النار التي أضرمها ومشاهد البيوت المحروقة وقوافل اللاجئين. اكتسب زيلينسكي شرعية المقاومة، وتحول بطلاً في نظر كثير من مواطنيه. بتصريحاته التي تذكر الغرب بمسؤولياته والخطر الذي يحدق بجيران بلاده، بدا زيلينسكي في صورة من يطلق النار على «فلاديمير الكبير» الذي لا يفتقر إلى صورة البطل لدى جمهور واسع في بلاده.
نادته الصدفة فذهب إلى موعده مع التاريخ. سيكون حاضراً حين يتحدث التاريخ عما فعله الرجل الذي جلس على عرش بطرس الأكبر وأطلق الانقلاب الكبير على العالم الذي اغتال الاتحاد السوفياتي وحرك بيادقه لتطويق بلاد ستالين.
الشرق الأوسط
———————————-
“الدون الهادئ”.. الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا/ بشير البكر
الكاتب ميخائيل شولوخوف، صاحب رواية “الدون الهادئ” الحائزة على جائزة نوبل 1965، يتحدر من أب روسي من منطقة “روستوف” على حدود ما بات يعرف بجمهورية لوغانسك الإنفصالية، ومن أمّ قوقازية أوكرانية أمّية، لم تتعلم القراءة إلا في سن الأربعين كي تتواصل مع ابنها. وتدور أحداث الرواية في منطقة شرق أوكرانيا، وهي كناية عن ملحمة حول تاريخ شعب “القوازق” (السلاف الشرقيين) في أوكرانيا، الذين كتب عنهم تولستوي رواية “القوازق” والكاتب نيكولاي غوغول رواية “تاراس بولبا”. ويعيش هذا الشعب تاريخياً على ضفاف الأنهار في هذه المناطق، ومنها نهر “الدون” الذي ينبع بالقرب من مدينة نوفوموسكوفيك ويصب في بحر آزوف. وتعتبر منطقة المصب وضفاف نهر الدنيبر من أغنى المناطق المشهورة بمزارع القوازق، الذين يربون الخيول ويزرعون الأرض ويعيشون حياة قبلية، ودخلوا في حروب مع روسيا منذ بطرس الأول، حينما مالوا إلى جانب شارل الثاني ملك السويد في معركة العام 1709، لكن ملكة روسيا كاترين الثانية عقدت معهم هدنة طويلة بعدما واجهت في 1773 حرب الفلاحين أو تمرد القوازق، وهذا ما منعهم خلال الثورة الروسية أن يقفوا إلى جانب البلاشفة والجيش الأحمر، وقاتلوا إلى جانب الجيش الأبيض.
“الدون الهادئ” واحدة من الروايات العالمية، التي أخذت نصيباً كبيراً من الجدل في القرن العشرين. عمل أدبي كبير من حيث الحجم، بأربعة أجزاء، صدر الجزء الأول منها، حينما كان شولوخوف في الثالثة والعشرين من عمره، لذلك شكك كثيرون في أن يكون قد كتب هذا العمل بمفرده، وأنه لا بد من فريق وقف وراء هذا الإنجاز. وكان أحد أبرز المشككين، الكاتب الروسي من أصل أوكراني، الكسندر سولجينتسين، حائز نوبل للآداب العام 1970، والذي جردته السلطات السوفياتية من جنسيته، وطردته إلى خارج البلد العام 1974، بعدما فضح في أعماله معسكرات الاتحاد السوفياتي للعمل القسري “الغولاغ”. واعتبر صاحب “أرخبيل الغولاغ” أن العمل “غير مسبوق في تاريخ الأدب، حيث ابتكر مبتدئ يبلغ من العمر 23 عامًا عملاً من مادة تجاوزت خبرته في الحياة ومستوى تعليمه”. وفي العام 1991، أذهل الصحافي ليف كولودني، عالم الأدب الروسي، بإعلانه أنه عثر على مخطوطات المجلدين الأول والثاني الأكثر إثارة للجدل في منزل في موسكو. وفي العام 1995 نشر تقريرًا مثيرًا عن بحثه عنها ووصفًا للمخطوطات. لقد كانت مكتوبة بيد شولوخوف بلا منازع، مع عمليات الحذف والتعديلات التي قام بها المؤلف، وتزامنت تواريخها تمامًا مع الحقائق المعروفة عن حياة شولوخوف الأدبية المبكرة.
والأمر الثاني هو أن الرواية التي صدر الجزء الأول منها في العام 1928، وكتبت المجلدات الأربعة منها على مدار 14 عامًا، بدءًا من العام 1926، أثارت عاصفة سياسية حول مضمونها في فترة حالكة من تاريخ الاتحاد السوفياتي، كان جوزيف ستالين يحكم خلالها قبضته الأمنية على كل شيء، فتعرض الكاتب للملاحقة والمطاردة والاعتقال العام 1932، لكنه هرب من السجن، ولم ينقذه من الموت إلا اللقاء مع ستالين مباشرة، والذي عفا عنه في بادرة غير معهودة عنه. وحصل شولوخوف على رقم هاتف الديكتاتور الشخصي، وكُلف بتنفيذ رؤية ستالين للأدب الروسي. والسبب الذي أثار للكاتب المتاعب هو أن الرواية تتناول الحرب العالمية الأولى، والحرب الأهلية الروسية وسيطرة الحكم السوفياتي على منطقة “الدون” أو “دون القوازق” حسب التسمية الدارجة، وتصف الرواية التي حازت على جائزة نوبل العام 1965 حياة شعب القوازق أنصار “الجيش الأبيض”، وتتطرق بالتفصيل إلى الصراع الذي كان دائرًا آنذاك بين أنصار الجيشين الأحمر والأبيض.
وتعرض المجلد الأخير من الرواية الذي نشر في العام 1940، وخصوصًا النهاية، إلى هجوم كبير من النقاد والقراء. وركزت الدراسات خصوصًا على شخصية بطل الرواية، غريغوري ميليخوف، التي تمر خلال فصول الرواية بالكثير من الأهوال، ويلحق به أذى عاطفي كبير نتيجة الحرب ومآسيها. وكان قراء الرواية في ذلك الزمن، لا سيما من أنصار الشيوعيين، راغبين في أن يختتم شولوخوف روايته بانضمام ميليخوف إلى صفوف الجيش الأحمر، غير أن نهايتها خالفت توقعاتهم؛ فقد بقي إلى جانب عائلته وأرضه في الريف الروسي الأوكراني. فهو رجل معتاد على العمل الفلاحي السلمي. “تصلح قدما غريغوري للدوس على الأرض”. تكمل هذه الجملة سيرة البطل، وترسم صورة لرجل مُعد للعمل والحياة الأسرية.
ويعتبر الكثير من النقاد الروس أن ذاكرة شولوخوف وخزانه الأدبي الحكائي، يأتي من ناحية الأم القوقازية الأوكرانية التي غذت ابنها بقصص وأساطير حياة شعبها وحروبهم ضد الروس وأبطالهم الشعبيين مثل تاراس بولبا. لذلك جاء عمله شديد الالتصاق ومفعم بالحميمية والتعاطف مع هذا الشعب، الذي رفض أن ينكس الراية للجيش الأحمر، وقاتل لسنوات قبل أن يقف إلى جانب روسيا في الحرب العالمية الثانية، وبرع مقاتلوه الفرسان بصورة أثارت إعجاب الأدب والموسيقى والسينما في روسيا.
وقدم شولوخوف، غريغوري، في الجزء الأول من الرواية، الذي ركز على عائلة والده المعروفة في قريتهم باسم الأتراك، لأن والدته كانت امرأة تركية أحضرها والده البطريرك إلى المنزل كغنيمة حرب، واتُهمت في ما بعد بالسحر وضربها القرويون الآخرون حتى الموت. ويظهر غريغوري في الرواية أفضل ممثل للقوزاق. يجسد براعة هذا الشعب في القتال والشجاعة التي يتحلى بها. فخور بأصله ولديه شعور كرامة نبيل، بينما يحترمه الرفاق وينظرون إليه كقائد.
ساءت الأوضاع في روسيا في الثلاثينيات، عندما انقلبت الحكومة الشيوعية على صغار المزارعين الناجحين. في ذلك الوقت، بدا هذا الموقف بالنسبة لقطاع واسع، بمن فيهم شولوخوف، بمثابة تجاوزات أو اعتداءات. وتبين لاحقًا أن العنف كان برنامجًا متعمدًا، أقره ستالين، من أجل إجبار الناس على المزارع الجماعية. والمأساة التاريخية تلك معروفة جيداً. وتختلف الأرقام، لكن ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص ماتوا جوعاً في أوكرانيا خلال العامين 1932 و1933 نتيجة لهذه السياسات المدمرة. وفي غضون ذلك، وضع شولوخوف نفسه في خطر سياسي لمساعدة الناس، وكان قادرًا شخصيًا على تأمين المساعدة لمنطقته. وبعد ذلك كلفه ستالين بكتابة رواية خيالية عن الجماعية، والتي نتج عنها المجلد الأول من رواية “الأرض البكر”، التي نُشرت في العام 1935. إن إجبار كاتب على تخيل محرقة بشكل إيجابي يبدو، وكأنه عقاب ألف ضعف على خطايا أي كاتب. ويبدو أن شولوخوف شعر بذلك عندما أصبح مدمنًا على الكحول بشكل خطير، لكن في روسيا في ذلك الوقت، لم يكن هذا نادرًا.
أصبح موضوع رواية “الدون الهادئ” مجالاً للبحث الأدبي والدراسات النقدية وللعديد من المؤرخين البارزين. مراجعات حول الرواية، وبعضها يدور حول الشخصية الرئيسية للعمل وفكرة الشخصية النموذجية. ووفقًا لغالبية النقاد، فإن غريغوري هو رمز للشعب الأوكراني كله، وليس للقوقازي فقط، صورة جماعية لكل من نجا من المأساة في سنوات الثورة، وكان هناك الملايين، لا سيما أن مصائر الناس العاديين في الرواية تحضر في المقدمة. وفي وقت لاحق، أصبح هذا النمط من الكتابة هو السائد لدى الكتّاب السوفيات، وغيرهم من الواقعيين الاشتراكيين، لكن شولوخوف لم يتقصد ذلك، هو الذي ابتكر أيضاً صور البطلات، ما أصبح، في ما بعد، الأكثر لفتًا للانتباه في تاريخ الأدب. أكسينيا المتحمسة، ناتاليا المحبة الهادئة، وداريا التافهة. ومع ذلك، هناك دائمًاً حرب تجلب المشقة والموت، ولا شيء أقوى منها. والمفارقة أن الرواية التي تضج بأهوال الحرب تدور على ضفاف نهر “الدون” الهادئ. واعتبر شولوخوف، إن تلك المهمة لم تكن سهلة.
المدن
———————–
قوزاق زابوروجيا بين السلطان محمد والقيصر بوتين/ صبحي حديدي
إيليا يفيموفتش ريبين (1844-1930)، الفنان الروسي الذي بات الواجب يقتضي اليوم التذكير بأنه أوكراني الأصل (على غرار الشاعرة الروسية الكبيرة أنا أخماتوفا، الأوكرانية بدورها)؛ هو الرسام الواقعي الأكثر شهرة، والأعلى كعباً أغلب الظنّ، في مشهد الفنون التشكيلية الروسية أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. له تدين الإنسانية بأعمال خالدة، بينها بورتريهات فاتنة لأمثال ليو تولستوي، ألكسندر بوشكين، مودست موسورسكي؛ وعدد من أصدق تمثيلات الفلاحين والعمال والكادحين، مثل لوحته الشهيرة «بحّارة على نهر الفولغا»؛ فضلاً عن أعمال قاسية المحتوى رهيبة الوقع، سُحب بعضها من العرض، مثل «إيفان الرهيب يذبح ابنه»، و»القديس نقولا في ليفيا»…
صحيح أنّ اجتياح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا هو الحافز الأسبق وراء استعادة ريبين في هذه السطور، من زاوية التشديد على حقّه في استرداد انتمائه الوطني الأوّل حيث مسقط رأسه؛ غير أنّ الحافز الأبرز هو لوحة ريبين الفريدة «القوزاق يسطّرون رسالة إلى السلطان التركي»، التي حملت وتواصل حمل سمات استثنائية على مستويات شتى تبدأ من فرادة فنية وتشكيلية تظل وراء طاقاتها الإيحائية الجبارة المستدامة، وفرادة في الرسائل المتعددة التي تنقلها في السياسة والثقافة والديانة والأسطورة والمقاومة، وفرادة ثالثة في تأثيراتها على مخيّلة عصور أدبية متعاقبة ومدارس وأساليب متباينة عابرة للحدود الروسية. هي لوحة تقع في 2,03 X 3,58، بالمقاييس المترية؛ وزمن إنجازها بدأ سنة 1880، وانتهى في 1891؛ ولم يتردد ألكسندر الثالث، إمبراطور روسيا وملك بولونيا ودوق فنلندا الأعظم، في دفع 35,000 روبل لشرائها مسجلاً الرقم القياسي لأغلى لوحة في زمنها؛ وهي اليوم معلّقة على أحد جدران متحف بطرسبورغ الحكومي. جذور موضوع اللوحة سوف نجدها في رواية نقولاي غوغول «تاراس بولبا»، وبالتالي سنراها أيضاً في الفيلمَيْن الروسي والأمريكي المأخوذَين عن الرواية؛ وأصداؤها سوف تتردد عند شاعر فرنسي غير منتظَر في هذا الحقل: غيوم أبوللينير !
اللوحة تصوّر نفراً من القوزاق، في حال من المرح والصخب والانتشاء والاعتداد والسُكْر، يتحلقون حول رفيق لهم يمسك بريشة ويخط على ورقة؛ ويحيل عنوان العمل إلى حكاية قوزاقية شائعة، لا يؤكدها السجلّ التاريخي ولا ينفيها تماماً، تروي أنّ ثلة من أبطال القوزاق بعثوا برسالة إنذار حافلة بالتحدي والوعد بالمقاومة إلى السلطان العثماني محمد الرابع، الذي شهد عهده توسّع السلطنة وبلوغها فيينا وبولونيا وهنغاريا وأطراف أوكرانيا. الرسالة، كما تتداولها الروايات الشعبية، طافحة بالشتائم المقذعة والألفاظ البذيئة، لكنها في المحصلة تعكس الكثير من خصال البسالة والجسارة والأنفة التي ميّزت القوزاق على مدار التاريخ؛ وهذه الروحية تحديداً هي التي منحت الحكاية، والرسالة إنْ وُجدت حقاً، جاذبية خاصة شدّت انتباه ريبين، وقبله غوغول، وبعدهما المغنّي/ الشاعر الفرنسي ليو فيريه.
وكي تتضح أكثر مكانة تلك الرسالة، خاصة في تكوّنها الأسطوري الذي خضع للكثير من التضخيم والتفخيم والتهويل، تجدر الإشارة إلى أنّ طرائق تناقلها في الأصقاع الأوروبية بدأت من الترجمة إلى الألمانية منذ سنة 1683، حيث لعبت دوراً مباشراً في رفع معنويات سكان فيينا خلال الحصار؛ كما تُرجمت إلى الإنكليزية، رغم أنّ سيف السلطنة لم يبلغ البرّ الإنكليزي. لافت، ولا يخلو من إثارة للعجب، أنّ حكاية الرسالة التي تشدّ أزر القوزاق في وجه الغزو العثماني، تُرجمت مجدداً إلى الإنكليزية بقصد إدراجها في كتاب برنارد غيرني «القارئ الروسي» الذي طُبع سنة 1947 وكان بمثابة الدليل المرشد إلى الحرب الباردة. تلك، وسواها، معلومات توفرت وانتشرت وأحاطت الرسالة بأسئلة مشروعة حول المصداقية بين ما هو موثوق ومقبول وما هو إنشاء وافتراء، غير أنّ رسالة القوزاق لم تخسر شيئاً من زخمها، بل إنّ الأحداث والوقائع والحروب اللاحقة زادت من جاذبيتها.
وفي العودة إلى ريبين، كان إغواء الرسالة أشدّ سطوة من أن يبعد الفنان الكبير عن المشروع بداعي التفريق بين الحقيقة والخرافة، لكنه في الآن ذاته لم يهبط بالعمل إلى سوية تحريضية جوفاء، واختار توثيقاً أفضل تبدّى بالفعل في دقّة الملامح على الوجوه، ولغة الأجساد المحتشدة حول كاتب الرسالة، والثياب والقبعات والأسلحة المطابقة للأصول القوزاقية. وإذْ يميل بعض ناقدي ريبين إلى إبداء تحفظ هنا أو هناك على المناخ العام في اللوحة، لجهة إظهار العربدة أو التكلّف أو الإفراط في تصوير مظاهر الانشراح والبهجة والجذل، فإنّ غالبية هؤلاء يعترفون أنه نأى بريشته عن التنميط الاستشراقي وتحقير الآخر العثماني؛ خاصة وأنّ نصّ الرسالة المتداول شعبياً، صحيحاً كان أم مزعوماً، يغمز مراراً من قناة الشرق والمشارقة.
وفي سنة 1880، وقبل أن يشرع في الرسم، زار ريبين غالبية مدن أوكرانيا من كييف إلى أوديسة، وتوقف خصيصاً في زابوروجيا ليرسم ما اعتقد أنه قبر المقاتل القوزاقي الشهير إيفان سيركو الذي سوف يحتلّ صدارة في لوحة الرسالة الشهيرة. الأقدار تشاء هذه الأيام، بعد مرور 142 سنة وتحت وابل القصف الروسي وأخطار الإشعاعات النووية، أن يجد أهل زابوروجيا أنفسهم أمام واجب تسطير رسالة مقاومة جديدة؛ ليس إلى سلطان عثماني هذه المرّة، بل إلى… القيصر بوتين!
القدس العربي
———————–
الصراع الروسي ـ الأوكراني في فضاءات اللغة والثقافة والكتب
تاريخ جدليّ طويل بين البلدين يعود إلى القرن التاسع الميلاديّ
لندن: ندى حطيط
لا يسهل فهم الصراع الروسيّ الأوكرانيّ الحالي في إطاره السياسيّ والعسكريّ فحسب، إذ بين هذين البلدين المترابطين بشكل لا ينفصم تاريخ جدليّ طويل يعود إلى القرن التاسع الميلاديّ على الأقل، تداخلت فيه الجغرافيا والعرقيّات والأديان، والإمبراطوريات، والثورات، والموارد. ولعل أوكرانيا المعاصرة التي كسبت استقلالها إثر سقوط الاتحاد السوفياتي السابق (1991) هي هبة هذا التاريخ الملتبس أبداً: مجموعات ترى أنها في مدار الثقافة الروسيّة ومزاج الشرق وتريد الاحتفاظ بعلاقة وديّة مع مركز الجاذبيّة للشعوب السلافيّة (الروس والبيلاروس والأوكرانيين)، وأخرى تحس بالاختناق من الأنفاس الروسيّة الثقيلة وتريد الانعتاق عبر التوجه إلى الغرب. وقد انعكست هذه العلاقة اللدودة على سيكولوجيا الأوكرانيين، واتخذت من فضاءات اللغة والكتب والأدب ومختلف تمظهرات الثقافة ساحة لها.
قبل ثورة يوروميدان عام 2014 – التي أطاحت بالسلطة المتحالفة مع موسكو لمصلحة قوميين أوكرانيين ذوي أهواء غربيّة – كانت ثلاثة أرباع الكتب المتداولة في أوكرانيا تأتي من روسيا وباللغة الروسيّة، ولكن ذلك الرقم انخفض بشكل دراماتيكيّ خلال السنوات التي أعقبت الثورة البرتقاليّة حتى كاد يقل عن 20 في المائة قبل الاجتياح الروسيّ الأخير. وقد فرضت السلطات الجديدة في كييف ترتيبات معقّدة تستوجب الحصول على موافقات مسبقة لاستيراد الكتب، وشددت العقوبات المفروضة على ناشرين روس كبار، كما حظر قرار صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في مارس (آذار) 2019، استيراد الكتب من تسعة ناشرين روس رئيسيين.
وبينما ذهب البعض إلى اعتبار تلك الإجراءات تمييزاً ضدّ الثقافة واللغة الروسيّتين، وتقييداً لحرية التعبير، فإن آخرين يقولون إن روسيا قمعت الثّقافة الأوكرانية، وبخاصة أثناء الحقبة السوفياتية، وهي مستمرّة حتى اليوم وبطرق متباينة باستخدام الثقافة كسلاح ضد السيادة الأوكرانية، وبالتالي فإن جهود حكومة كييف في هذا الاتجاه قد تكون وسيلة ضرورية للدّفاع ضد قوة عملاقة عدوانية تسعى إلى إلغاء أوكرانيا من خريطة العالم.
من وجهة نظر اقتصادية محضة، فإن تقييد توارد الكتب من روسيا يهدف إلى دعم الناشرين الأوكرانيين في مواجهة منافسة لا ترحم من دور النشر الروسيّة التي تتمتع بسوق كبير تمنحها فائدة حجم تفضيليّة دائمة. لكن بعد التضييق على الكتاب الروسيّ لوحظت زيادة ملموسة في حركة النشر الأوكراني، وأصبح كثير من الكتب التي تصدر في روسيا يُعاد نشرها مرّة أخرى مترجمة إلى الأوكرانية، في أوكرانيا.
لكن السلطات الأوكرانيّة لا تعترف بوجود حظر عام على الكتب الروسيّة وإنما مجموع إجراءات فرضت منذ 2017 لضمان عدم تسرّب أدب الكراهيّة والعداء لأوكرانيا إلى داخل البلاد. وفي الحقيقة، فإن أي كميّة لا تزيد على عشر نسخ لا تخضع لتلك الإجراءات، ولكن عندما ينوي تجار الكتب استيراد كميّات كبيرة فعليهم أن يحصلوا على إذن رسميّ لضمان ألا يتعارض محتوى الكتاب مع القيم الديمقراطية، مثل: «التنصل من استقلال أوكرانيا»، أو «تشجيع العنف»، أو «التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية»، أو «تمجيد الإرهاب وأي انتهاك لحقوق الإنسان والحريات». وقد تم تأسيس دائرة حكومية متخصصة للنظر لتنفيذ تلك الإجراءات والسّيطرة على توزيع المواد المطبوعة.
> كانت ثلاثة أرباع الكتب المتداولة في أوكرانيا تأتي من روسيا وباللغة الروسيّة، لكن ذلك الرقم انخفض بشكل دراماتيكيّ
خلال السنوات التي أعقبت «الثورة البرتقاليّة»
> بحسب أرقام حكوميّة، فإن مساهمة القطاع الإبداعي
في الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا تجاوزت الـ5 في المائة،
بينما كانت تستورد خمسة أضعاف إنتاجاتها الثقافية
ويدرك المسؤولون الأوكرانيون أن المظهر العام لتلك التوجهات للتضييق على تداول الكتاب لا يساعد في بناء صورة صحيحة عن الممارسة الديمقراطيّة في البلاد، ولكنّهم يعتمدون على مواطنيهم لناحية وضعها في منظورها الصّحيح ضمن السّياق الأكبر للأمور.
فعلى الأرض، وبحكم التاريخ السّوفياتي المشترك، كانت الغلبة ولوقت قريب للإنتاجات الثقافيّة الروسيّة: الأفلام السينمائية والتلفزيون والكتب وموسيقى البوب مقابل مواد قليلة باللغة الأوكرانية. ولا شكّ أن بعض الأفكار التي قد تتسرب من خلال الكتب الروسيّة، لا سيّما بعد 2014 تضم إشارات تمسّ السلامة الإقليمية لأوكرانيا، أو تعد تحريضاً على الكراهية العرقية والدينية، لا سيّما بعد نشوء الصراع المسلّح شرق أوكرانيا بين حكومة كييف والانفصاليين ذوي الأصول الروسيّة ودعم موسكو لهم.
وبغض النّظر عن مبررات تلك الإجراءات، فإن من نتيجتها أن ازدهرت أعمال النشر باللغة الأوكرانيّة وتضاعف معدل عدد النسخ المنشورة من الكتاب الواحد كما عدد العناوين في مختلف مجالات الأدب والفكر، فيما تراجع تداول ونشر الكتب بالروسيّة لا سيّما بعد أن أصبح التعليم بالأوكرانية إجبارياً في مدارس البلاد، بدءاً من عام 2020 – رغم وجود أقليّة روسيّة يزيد عددها على 8 ملايين نسمة في الجمهوريّة التي يصل مجموع عدد سكانها إلى نحو 45 مليوناً.
كما تدعم جهات حكوميّة ومؤسسات شبه حكوميّة – مثل الصندوق الثقافي الأوكراني ومعهد الكتاب الأوكرانيّ والمؤسسة الثقافيّة الأوكرانيّة – بسخاء تمويل ترجمات من إنتاجات كتاب أوكرانيين إلى لغات غربيّة إضافة إلى دعم الإنتاج الثقافيّ بشكل عام.
هذا الازدهار غير المسبوق في إنتاج الكتب أتاح للقطاع الإبداعيّ باللغة الأوكرانيّة (كالأغاني والموسيقى والأفلام والفيديو) هوامش أوسع للانتشار، ما انعكس إيجاباً على الثقافة الوطنيّة والاقتصاد القوميّ على حد سواء.
وبحسب أرقام حكوميّة، فإن مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 5 في المائة، وبينما كانت أوكرانيا تستورد خمسة أضعاف إنتاجها من الإنتاجات الثقافيّة، فإن الأرقام متعادلة الآن بين الصادرات والواردات.
ورغم أنّ صناعة الكتب والعوالم الثقافية ستكونان من أوّل المتأثرين بالحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانيّة، فإنّ التضامن الغربيّ الواسع إثر الاجتياح الروسّي الأخير سيفتح دون شك آفاقاً لا نهائيّة أمام الأدباء والمفكرين الأوكرانيين، ولن يُستغرب إن قررت مؤسسة نوبل منح جائزتها المرموقة للأدب لأديب أو أديبة من تلك البلد بعد أن عاندتها كثيراً.
وكانت آخر محاولة جادة لمنح تلك الجائزة لكاتب أوكرانيّ تعود إلى الثمانينات عندما طرح اسم الشاعر والمنشق الأوكراني فاسيل ستوس لمنحه الجائزة أثناء احتجازه في سجن سوفياتي، غير أنه ما لبث توفي في ظروف مريبة قبل بدء عملية تقديم الترشيحات.
ويعد النقّاد أنّ ولادة الأدب الأوكراني الجديد بدأت بنشر رواية «موسكوفياد (Moscoviad)- 1992» ليوري أندروخوفيتش التي تُرجمت إلى الإنجليزيّة في 2009. وتحكي الرواية التي تذكرنا برائعة جورج أورويل (1984) عن ملامح التفكك في الإمبراطوريّة باستخدام الواقعيّة الخياليّة لنقل أجواء العيش في عالم بائس خلال يوم واحد في موسكو. وواصلت أوكسنا زابوشكو نقل الأدب الأوكراني بعيداً عن الأجواء السوفياتيّة فكتبت روايتها الاستفزازيّة «عمل ميدانيّ في الجنس الأوكراني (Fieldwork in Ukrainian Sex) – 1996» وطرحت فيها ثيمات نسويّة وسياسيّة مثيرة للجدل وكسرت كثيراً من التابوهات الاجتماعيّة حتى عدّت العمل الأدبي الأكثر تأثيراً منذ الاستقلال.
ومن الكتّاب المشهورين اليوم: سيرهي زهادان الشاعر والكاتب من إقليم دونباس المتنازع عليه والمعروف بتصويره للمجتمع الأوكراني، كما هو وليس بصورة مثاليّة، ما جلب له شعبيّة كبيرة بين الشبّان، وأيضاً فاسيل شكيار الذي باعت روايته «طريق الغراب (Raven’s Way) – 2009» أكثر من 300 ألف نسخة، وهو رقم قياسيّ للكتب المنشورة في أوكرانيا. ويعيد شكيار من خلال روايات تاريخيّة استكشاف نضال الأوكرانيين المجهول لأجل الاستقلال عن روسيا عبر 300 عام، لا سيّما في العصر السوفياتيّ.
ومع ذلك، فإن هؤلاء الذين وصلت أعمالهم إلى اللغات الأجنبيّة يبقون أقليّة، إذ لا يزال عشرات المؤلفين الأوكرانيين الجدد ينتظرون من يترجم لهم أعمالهم كي تجد الاعتراف بجدارتها على النّطاق الدولي. وسيكون من سخرية القدر أنّ الاجتياح الروسيّ لبلادهم هو تحديداً ما سيمنحهم الفرصة لذلك.
الشرق الأوسط
—————————————
كيف يمكن أن ينتهي الهجوم الروسي على أوكرانيا؟ 5 سيناريوهات أغلبها لا يبشر بالخير لبوتين
عربي بوست
كيف قد يكون شكل النهاية بالنسبة للهجوم الروسي على أوكرانيا؟ الرئيس فلاديمير بوتين يسميها عملية عسكرية خاصة لكن مسارها يشير إلى حرب شاملة، فهل تكون قصيرة أم طويلة الأمد؟ سيناريوهات متعددة لتلك النهاية.
كان الرئيس الروسي قد أعلن الخميس 24 فبراير/شباط الماضي عن شن ما سمّاها عملية عسكرية خاصة هدفها “منع عسكرة أوكرانيا”، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال لوغانسيك ودونيتسك، المنطقتين الانفصاليتين في إقليم دونباس الأوكراني المتاخم للحدود الروسية.
ومع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثاني عشر، تحاصر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف والمدن الكبرى الأخرى مثل أوديسا وماريوبول وخاركيف، بينما يحقق الانفصاليون المدعومون من موسكو في إقليم دونباس انتصارات صغيرة على الجيش الأوكراني، لكن الواضح أن الأمور لا تسير كما خطط لها بوتين، بحسب أغلب التحليلات السياسية والعسكرية.
سيناريو الحرب القصيرة.. سحق أوكرانيا!
الحديث الآن في الدوائر السياسية والعسكرية حول العالم يدور حول السيناريوهات التي قد يسدل بها الستار على ذلك الهجوم على أوكرانيا، أو الغزو كما يسميه الغرب. وعلى الرغم من أنه لا أحد يمكنه الجزم يقيناً بما قد تؤول إليه الأمور، فإن أغلب التحليلات تحصر السيناريوهات المحتملة في عدد قليل من الاحتمالات أولها سيناريو الحرب القصيرة.
وبحسب تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، ينطوي هذا السيناريو على قيام الجيش الروسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بتصعيد عملياته العسكرية، وهو ما يعني على الأرجح زيادة القصف المدفعي والصاروخي في مختلف المناطق بأوكرانيا. كما يرجح أن تشن القوات الجوية الروسية، التي لم يكن لها دور كبير حتى الآن، غارات مدمرة، وأن تتعرض المؤسسات الأوكرانية الرئيسية إلى هجمات الكترونية واسعة.
أوكرانيا
وتتواصل عمليات قطع الاتصالات وموارد الطاقة بشكل كامل، وعلى الرغم من المقاومة الشرسة التي يبديها الجيش الأوكراني حتى الآن، من المرجح أن تسقط كييف خلال أيام، ولكن قد تكون تكلفة هذا السيناريو البشرية، خصوصاً بين المدنيين مرتفعة للغاية. وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء موافقة موسكو الإثنين 7 مارس/آذار على وقف مؤقت لإطلاق النار في كييف كييف وماريوبول وخاركيف وسوم جومشافت لتأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين، استجابة لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي حالة تحقيق القوات الروسية للسيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى، على الأرجح ستقوم موسكو بعزل حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومحاكمة أعضائها حال اعتقالهم، واستبدالها بحكومة موالية لروسيا. وإذا ما تمكن زيلينسكي من الهروب خارج أوكرانيا، سعلن تشكيل حكومة في المنفى تعترف بها الدول الغربية.
وفي هذا السيناريو من المتوقع أن يعلن بوتين الانتصار في أوكرانيا ويسحب بعضاً من القوات الروسية، تاركاً جزءاً منها للسيطرة على الأوضاع، بينما سيواصل عشرات الآلاف من الأوكرانيين الخروج من البلاد، وبهذا تتحول أوكرانيا إلى دولة وضعها أشبه كثيراً بوضع بيلاروسيا، حليفة موسكو وتابعتها.
سيناريو “المستنقع الأوكراني”
أو سيناريو الحرب الطويلة، وفيه يتحول الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى صراع طويل الأمد، تفشل فيه محاولات القوات الروسية السيطرة على المدن الأوكرانية، وقد يكون السبب في ذلك هو شراسة المقاومة الأوكرانية المدعومة بالأسلحة والمتطوعين من الغرب، مع ضعف معنويات القوات الروسية وارتفاع خسائرها البشرية والمادية.
وربما يتحقق هذا السيناريو أيضاً إذا طالت المدة الزمنية التي تسبق دحول القوات الروسية إلى المدن الأوكرانية، وتحول شوارع تلك المدن إلى حرب عصابات يشنها الأوكرانيون المدعومون من متطوعين غربيين تحول الهجوم الروسي إلى مستنقع أو فخ لا يستطيع الروس الفكاك منه، في تذكير بالغزو السوفييتي لأفغانستان والذي استمر نحو 10 سنوات وانتهى بالانسحاب المهين للقوات السوفييتية.
وفي مقال له في صحيفة New York Times، وصف الكاتب الأمريكي توماس فريدمان سيناريو الحرب الطويلة بسيناريو “المصيبة الكبرى” ويقول إنه بالفعل السيناريو الذي يشاهده العالم حالياً “ما لم يتراجع بوتين أو يجبره الغرب على التراجع”. ويعتقد فريدمان أن بوتين يبدو مصمماً على “تدمير أكبر قدر من أوكرانيا كدولة وقتل عدد كبير من أهلها حتى يمحو أوكرانيا نفسها كدولة حرة ومستقلة ويبيد قيادتها وثقافتها”.
وبحسب فريدمان قد يؤدي هذا السيناريو إلى جرائم حرب لم تشهد أوروبا لها مثيلاً منذ جرائم النازية، وهي جرائم قد تحول “بوتين ودائرته المقربة إلى جماعة منبوذة دولياً”. لكن ستكون هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيه دولة بحجم وإمكانيات ووضع روسيا السياسي دولة منبوذة دولياً. فموسكو تمتلك مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي ومساحتها الجغرافية تمتد على نطاق 11 منطقة زمنية كما أنها واحد من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، وفوق كل ذلك تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس النووية على الإطلاق.
السيناريو نفسه ظهر أيضاً في دراسة لمعهد أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن بعنوان “سيناريو المستنقع”، تحدث أيضاً عن احتمال تحول أوكرانيا إلى مستنقع مكلف مادياً وبشرياً بالنسبة لروسيا، بسبب شراسة واستمرارية المقاومة الأوكرانية حتى بعد تمكن الجيش الروسي من دخول المدن الكبرى وإعلان حكومة موالية لموسكو.
وبحسب تحليل المجلس الأطلسي يبدو أن روسيا قد تواجه هذا “النمط المتكرر حول العالم، حيث تكبد المقاومة الأوكرانية قوات موسكو خسائر مادية وبشرية ضخمة مما يضطر الكرملين إلى تكريس أعداد وكميات أكبر من جيشها ومواردها للحفاظ على مكاسبها الميدانية في أوكرانيا”.
والملاحظ هنا أن القاسم المشترك في جميع التحليلات بشأن هذا السيناريو تحديداً هو أن وقوعه مرتبط باستمرار الغرب في تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة النوعية للمقاومة الأوكرانية، إلى جانب توصيل “المتطوعين الراغبين في القتال ضد القوات الروسية” إلى الأراضي الأوكرانية، وهو ما يبدو واضحاً بالطبع أنه سيستمر.
سيناريو الحرب العالمية
قد تخرج الأمور عن نطاقها الحالي، أي هجوم روسي على الأراضي الأوكرانية فقط، ومن ثم تمتد إلى دول أخرى في القارة الأوروبية أو حتى إلى ما هو أبعد من ذلك. وعلى الرغم من أن جميع الأطراف تبدو حريصة حتى الآن على عدم اتساع نطاق الحرب المشتعلة حالياً، فإن هذا السيناريو المحتمل يبدو وارداً.
سيناريو “الحرب بين روسيا والناتو”، بحسب تسمية تحليل المجلس الأطلسي، يعتبر السيناريو الأكثر خطورة ليس فقط لمستقبل أوروبا بل للنظام العالمي القائم حالياً، وقد يتحقق هذا السيناريو إذا ما أدى الصراع الأوكراني إلى “تهيئة المسرح لمواجهة عسكرية مباشرة بين حلف الناتو وروسيا”.
ورصد التحليل عدة مسارات قد تؤدي إلى هذا السيناريو المرعب، منها أن يقرر الناتو، في لحظة ما، المشاركة بفاعلية أكبر في الدفاع عن أوكرانيا من خلال فرض منطقة حظر جوي أو أي شكل آخر من أشكال التدخل يعتبرها بوتين “إعلان حرب” من جانب الحلف، فيقرر مهاجمة دول البلطيق أو بولندا على سبيل المثال وهي أعضاء في الناتو. أو قد تضرب روسيا، ولو عن طريق الخطأ، منطقة أو أرضاً تابعة لدولة حلف في الناتو كبولندا أو دول البلطيق، كأن يسقط صاروخ بعيد المدى فترد تلك الدولة وتشتعل المواجهة. أما المسار الآخر فيتعلق بأن يكون لدى بوتين من الأصل خطط أخرى تتعلق بدول جوار ليست عضواً في الناتو كمولدوفا، ويهاجمها أيضاً فيقرر الناتو أن يصعد من موقفه ضد موسكو.
والسيناريو نفسه رصده تحليل BBC تحت وصف “الحرب الأوروبية”، وفيه أيضاً احتمال سعي بوتين إلى استعادة أجزاء من الإمبراطورية الروسية السابقة، فيرسل قواته إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، مثل مولدوفا وجورجيا وهما ليستا في حلف الناتو. وقد يكون الأمر مجرد تصعيد وحسابات خاطئة. وقد يعلن الرئيس بوتين أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة عُدوان يتطلب الردّ.
تعزيزات الناتو في أوروبا الشرقية، على إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا/رويترز
وقد يهدد بإرسال قواته إلى دول البلطيق وفتح ممر أرضي إلى الجيب الروسي الخارجي الساحلي كالينينغراد، وسيكون هذا الأمر بالغ الخطورة وقد ينذر بحرب مع حلف الناتو، إذ تنصّ المادة الخامسة من ميثاق التكتل العسكري على أن أي اعتداء على عضو واحد في الحلف، هي اعتداء على جميع الأعضاء.
لكن الأمر الوحيد الذي يبدو أن عليه إجماعاً بين المحللين فيما يخص هذا السيناريو مرتبط بالأساس بالرئيس الروسي، بمعنى أن بوتين، الذي أمر بالفعل بوضع أسلحة روسيا النووية في حالة “تأهب خاص”، قد يلجأ إلى التصعيد غير المتوقع إذا ما وجد نفسه “محشوراً في الزاوية” بشكل كامل.
فالعقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا هي بمثابة “قنبلة نووية اقتصادية”، بحسب تعبير فريدمان في مقاله، بالإضافة إلى عدم تمكن الجيش الروسي من تحقيق انتصار سريع على الأرض ومدى شراسة وقوة المقاومة الأوكرانية وارتفاع معدل الخسائر الروسية، فإن هذه جميعاً عوامل تضعف
موقف بوتين داخلياً وتهدّد بإرخاء قبضته الحديدية على الحكم. وإذا ما شعر بوتين بالفعل بأنه مهدد بفقدان حكمه لروسيا، لا أحد يمكنه توقع خطوته التالية.
سيناريو الحلول الدبلوماسية
وقد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، فالحرب قد اندلعت ودخانها يتصاعد والقتلى يتساقطون واللاجئون الأوكرانيون يغادرون بعشرات الآلاف يومياً. لكن النهاية لأي حرب لا تتم عادة إلا بالتوصل إلى حل دبلوماسي، خصوصاً إذا ما فشلت الحرب في حسم الصراع لصالح أحد الطرفين بشكل واضح.
ويسمي فريدمان هذا الاحتمال بسيناريو “الحلول الوسط القذرة”، ويتوقعه الكاتب الأمريكي في حالة فشل الجيش الروسي في تحقيق انتصار عسكري حاسم وسريع من جهة وفشل الأوكرانيون في الحفاظ على تماسكهم من جهة أخرى.
يقول فريدمان إن هذا السيناريو قد يكون وارداً في حالة تماسك الجيش والشعب الأوكراني في وجه الهجوم الروسي فترة كافية، حتى يبدأ تأثير العقوبات في الظهور على الاقتصاد الروسي، وفي هذه الحالة قد يشعر الطرفان (روسيا وأوكرانيا) بالرغبة في قبول “حلول وسط قذرة”، تتمثل في وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية. وفي مقابل ذلك، يتم التنازل رسمياً لروسيا عن شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس وتعلن كييف رسمياً عدم انضمامها للناتو أبداً. وفي الوقت نفسه تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون رفعاً فورياً للعقوبات التي تم فرضها على روسيا.
وبينما يستبعد فريدمان هذا السيناريو أو يراه أقل ترجيحاً لكونه يعني اعترافاً من بوتين بفشله في تغيير الحكومة الأوكرانية وضم أوكرانيا ككل لروسيا، إلا أن بوتين نفسه لم يعلن عن رغبته في ضم أوكرانيا إلى روسيا، وبالتالي قد يوافق الرئيس الروسي على حل دبلوماسي بتلك الشروط ويمكنه تسويقه داخلياً على أنه انتصار، بحسب محللين آخرين.
ويصف تحليل BBC الحل الدبلوماسي بأنه ما زال ممكناً، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “السلاح نطق الآن، ولكن لا بد أن يبقى طريق الحوار مفتوحاً”. والحوار متواصل فعلاً، إذ يتحدث ماكرون إلى الرئيس بوتين هاتفياً.
ونقلت الـ”بي بي سي” عن دبلوماسيين قولهم إن الغرب يواصل استشعار مواقف موسكو. كما أن المسؤولين الروس والأوكرانيين أحدثوا مفاجأة عندما التقوا لإجراء محادثات على الحدود مع بيلاروسيا. وإن كانت المحادثات لم تحقق أي تقدم، فإن بوتين على الأقل قبل باحتمال التفاوض على وقف إطلاق النار.
سيناريو رحيل بوتين
أما السيناريو الأخير الذي يرى فريدمان أنه الأقل ترجيحاً بين سيناريوهات النهاية للهجوم الروسي على أوكرانيا فهو أن يفشل بوتين في تحقيق أي من أهدافه وتتحول أوكرانيا إلى أفغانستان أخرى للرئيس الروسي، وتظهر تداعيات العقوبات الاقتصادية فتنتشر وتيرة الرفض الشعبي الروسي لعملية أوكرانيا، مما يؤدي في نهاية المطاف إما إلى قرار شخصي من بوتين بالانسحاب من المشهد تماماً أو أن ينقلب عليه قادة الجيش الروسي.
لكن الكاتب الأمريكي نفسه يرى أن هذا السيناريو قد لا يكون غير وارد لعدد من الأسباب أهمها شخصية بوتين وثانيها سيطرته المطلقة على مقاليد الأمور في روسيا وتمتعه بولاء مطلق من المحيطين به، وإن كان فريدمان لم يخفِ أن هذا السيناريو يعتبر نموذجياً بالنسبة للناتو والاتحاد الأوروبي بالطبع.
ووصف تحليل الـ”بي بي سي” هذا السيناريو بـ”الإطاحة ببوتين”، الذي صرح عندما أعلن بدء الهجوم على أوكرانيا قائلاً: “نحن مستعدون لأي نتيجة كانت”. ولكن ماذا لو كانت النتيجة أن يفقد السلطة؟ يبدو الأمر بعيداً عن التصور.
ولكن العالم تغير في الأيام الأخيرة، ومثل هذه الأمور يجري التفكير فيها فعلاً. فقد كتب البروفيسور السير لورنس فريدمان، أستاذ الدراسات الحربية في كينغز كوليدج في لندن: “تغير النظام محتمل اليوم في موسكو مثلما هو محتمل في كييف”، بحسب تحليل البي بي سي.
لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ ربما لأن بوتين يخوض حرباً كارثية. فآلاف الجنود الروس يموتون. ربما هناك مخاطر باندلاع ثورة شعبية. ويلجأ بوتين إلى قوات الأمن الداخلي لقمع هذه الثورة. ولكن الأمور قد تنفلت من يديه، فينقلب عليه عدد كافٍ من السياسيين والعسكريين والنخبة.
يقول الغرب إذا رحل بوتين وحل محله قائد معتدل فإن العقوبات ستخفف عن روسيا وتعود العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها مع موسكو. وقد يحدث انقلاب عسكري دموي فيترك بويتن السلطة. ولا يبدو هذا الأمر أيضاً مرجحاً الآن. ولكنه ليس مستبعداً إذا شعر الأشخاص المستفيدون من بوتين بأنه لم يعد قادراً على حماية مصالحهم.
الخلاصة هنا أن هذه السيناريوهات جميعاً قد تكون واردة واحتمال تحقق أي منها لا ينفي احتمال تحقق الآخر، فقد تتداخل معاً كأن تطول الحرب وتتحول إلى مستنقع فيؤدي ذلك إما إلى الإطاحة بالرئيس الروسي أو التوصل إلى حلول دبلوماسية.
—————————
ألمانيا تحت ترددات الحرب الأوكرانية… عودة إلى زمن العسكر/ إميل أمين
هل أخطأت أميركا وأوروبا في حرمان الألمان من بناء جيش نظامي قوي بعد الحرب العالمية الثانية؟
بعد ساعات من اندلاع المعارك على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كان قائد الجيش الألماني، الجنرال الفونس ميس، يعلن عن إحباطه إزاء ما يراه إهمالاً طويل الأمد للجاهزية العسكرية في بلاده، ومعتبراً أن الجيش الألماني في وضع سيئ.
كتب الجنرال الألماني عبر وسيلة التواصل “لينكد إن”، ما نصه “في السنة الحادية والأربعين من خدمتي العسكرية، وفي وقت السلم، لم أكن لأفكر في أنني سأضطر إلى اختبار حرب. والجيش الألماني الذي أتشرف بقيادته خالي الوفاض إلى حد ما. الخيارات التي يمكننا تقديمها للحكومة لدعم الناتو محدودة جداً”.
يعن للقارئ أن يتساءل: هل هذه مشاعر ندم على الأوضاع العسكرية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، التي تسببت فيها الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول الحلفاء في منع ألمانيا من بناء جيش نظامي، أم أنها بدايات صحوة تسعى إلى إعادة بناء الجيش الألماني الذي أخاف الجميع فيما مضى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن هناك حقيقة مؤكدة أثبتتها التجربة، وهي أنك إن أردت السلم عليك أن تستعد للحرب، ويبدو أن الألمان لم يكن ليخطر على بالهم السعي من جديد في طريق بناء جيوش نظامية، فقد غربت فكرة الحرب عن القارة العجوز، وذلك قبل أن يعود الرئيس الروسي ويكشف عن أوراقه ويظهر للعالم أنه قادر على تهديد الأمن والسلم الدوليين.
هل المشهد الخاص بالعودة إلى زمن التسلح يتوقف على ألمانيا فقط، أم ينسحب كذلك على اليابان؟
في واقع الأمر كان الحديث في الداخل الياباني أعلى صوتاً من نظيره في ألمانيا، لا سيما في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الرجل الذي امتلكت بلاده في زمنه قدرة على رفض ما فرض عليها من قيود بعد الهزيمة القاسية في الحرب العالمية الثانية… هل من المزيد من فك طلاسم المشهدين العسكريين الألماني والياباني؟
البنادق الألمانية… حديث بعد صمت طويل
في الثامن من مايو (أيار) عام 1945، دخل الاستسلام الألماني غير المشروط حيز التنفيذ، صمتت البنادق الألمانية منذ تلك اللحظة، واستسلمت كل الرتب الألمانية لكل القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للقائد الأعلى لقوات التحالف، وفي الوقت نفسه أيضاً للقائد الأعلى للقوات السوفياتية.
عانت ألمانيا منذ ذلك الحين شروط الحلفاء المجحفة طوال عشر سنوات، وذلك قبل أن يسمح بتأسيس جيش ألمانيا الحديث في 5 مايو من عام 1955.
بلغ عدد أفراد الجيش الألماني خلال الحرب البارة نحو 495 ألف فرد، إضافة إلى قوات احتياط تبلغ نصف مليون آخرين.
ولعله من المثير أنه بعد سقوط جدار برلين، وإعادة توحيد شطري ألمانيا، اشترطت اتفاقية “2+4” الموقعة بين الألمانيتين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا، على أن لا يتجاوز قوام جيش ألمانيا الموحدة 285 ألف فرد، وهو الأمر الذي لا يزال محل التزام حتى الساعة.
علامة الاستفهام في هذا المقام مزدوجة، والبداية من: هل ما يزال الألمان قانعين بتلك الأعداد، أم أنهم يدركون أنه حان وقت تغييرها، واسترداد القرار مرة أخرى من براثن الأميركيين والأوروبيين، فضلاً عن الروس الذين باتوا مهدداً حقيقياً في الوقت الراهن لأمن أوروبا برمتها، وليس فقط ألمانيا، وتالياً ما الذي تخشاه الأطراف الأخرى من الصحوة الألمانية، بمعنى هل لا تزال هواجس ألمانيا التي كانت يوماً ما نازية تخيف الأجيال الأوروبية الجديدة، قبل الأميركية، على الرغم من نأي الجيش الألماني الحالي بنفسه عن التقاليد العسكرية للحقبة الهتلرية من جهة، وتأسيسه تقاليد جديدة كجيش يليق ببلد ديمقراطي من ناحية أخرى؟
تبدو هيكلية الجيش الألماني مغايرة لكثير من الجيوش الأوروبية، فعلى سبيل المثال يعين وزير الدفاع الألماني من السياسيين المدنيين، وليس بالضرورة أن يكون من العسكريين، ويعد القائد الأعلى للجيش في زمن السلم… ماذا عن زمن الحرب؟
تنتقل السلطة تلقائياً إلى مستشار البلاد، ويقوم وقتها بمعاونته وزيرا دولة من المدنيين، عطفاً على المفتش العام للجيش، وهو منصب يعادل رئيس الأركان، وغالباً ما يكون جنرالاً توكل إليه المهام العسكرية المتخصصة.
فوق كل ذلك هناك ما يعرف بـ”لجنة الدفاع” في البرلمان الألماني، ومهمتها مراقبة كل ما يتعلق بأنشطة وعمل القوات المسلحة الألمانية، بالتعاون مع مفوض خاص يعينه البرلمان لشؤون الجيش، ويوكل إليه مهمة متابعة الأوضاع العامة للجنود والضباط والقادة بالقواعد العسكرية وحالة الأسلحة.
ألمانيا ونهاية “الطابع التحريمي” الغربي
ليس سراً أن أصواتاً ألمانية عديدة قد ارتفعت في العقدين الأخيرين، ومع بداية الألفية الجديدة، مطالبة بوضع حد للقيود المفروضة على العسكرة الألمانية، وبعد مرور نحو سبعة عقود هي عمر ما عرف بـ”الطابع التحريمي”، أي منع ألمانيا من بناء قوات مسلحة جديدة يمكنها عند لحظة معينة أن تكون الرقم الصعب في الداخل الأوروبي أول الأمر.
على جانب آخر، عادت الحركات اليمينية الألمانية المتشددة إلى الساحة، بل إن البعض منها استطاع التسلل إلى داخل صفوف القوات المسلحة الألمانية، وهذه بدورها ترى أن ألمانيا قد تعرضت لظلم شديد طوال العقود السبعة الماضية، وأنه حان الوقت لأن يطفو على سطح أوروبا والعالم جيش ألماني يليق بمقدرات الشعب الألماني.
والشاهد أن تصريحات الجنرال ميس قائد القوات المسلحة الألمانية، قد وجدت ترحيباً كبيراً في صفوف الألمان، ووصفت بأنها “صادقة جداً”، بل وحمل كثيرون الذنب للحكومات الألمانية خلال العشرين سنة الماضية، وبخاصة مسألة تخفيض المخصصات المالية اللازمة لبناء قوات عسكرية كفيلة بملاقاة النوازل كما حدث أخيراً مع بوتين.
في تعليقه الأخير، بدا واضحاً أن الشعور بالتقصير يعصف بالجنرال ميس، لا سيما بعد أن فقدت المستشارة السابقة ميركل القدرة على التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعدما ضمت روسيا بقوة السلاح شبه جزيرة القرم عام 2014، وباتت الآن أمام استحقاقات مشهد أكثر هولاً متمثلاً في غزو روسيا لأوكرانيا، والاحتمالات المفتوحة لأن تنفتح شهية القيصر إلى غزو بعض دول البلطيق أو ما وراءها.
قبل تصريح الجنرال ميس، بدا أن هناك ميلاً واضحاً من الكثير من الشباب الألمان من المعتدلين، وقبل اليمينيين، للانخراط في سلك الجندية، وإبراز الوعد الذي نصه “أنذر نفسي لخدمة جمهورية ألمانيا الاتحادية بوفاء والدفاع بشجاعة عن حق الشعب الألماني وحريته”.
هذا الوعد الذي يردده الشباب الألماني أمام عموم الألمان قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية، لقي تشجيعاً من كل الأطراف، بدءاً من مسؤولي وزارة الدفاع، ومن أطراف فاعلة قوية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحتى من مسؤولين دينيين كنسيين مثل الأسقف البروتستانتي العسكري زيغورد ريك ساند.
100 مليار يورو… طريق ألمانيا لجيش قوي
نهار الأحد 27 فبراير (شباط) الماضي كان المستشار الألماني أولاف شولتز، يعلن أن بلاده ستخصص 100 مليار يورو لقواتها المسلحة، ومضيفاً “من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في أمن بلدنا من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا”… هل هي بداية جديدة لجيش ألماني مغاير عما جرت به المقادير منذ عام 1955 وحتى الساعة؟
في واقع الأمر بدأت الرغبة الألمانية في العودة عسكرياً إلى العالم قبل أزمة أوكرانيا بنحو عقدين من الزمن تقريباً، كان ذلك في عام 1994، عندما طلب الحلفاء من ألمانيا المشاركة في عمليات عسكرية خارج البلاد، وساعتها كان الدستور الألماني هو العقبة في الطريق إذ يحصر مهمة الجيش داخل البلاد فقط.
في ذلك الوقت بدا الخلاف واسعاً حول شرعية المشاركة في عمليات عسكرية خارج الأراضي الألمانية، إلى أن تدخلت المحكمة الدستورية وقضت بشرعية مشاركة الجيش الألماني في عمليات عسكرية خارج البلاد، بشرط أن يتم ذلك في إطار المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو حلف “الناتو”، ووجوب موافقة البرلمان على تلك العمليات الخارجية، وهكذا بدأ توجه جديد في السياسات الخاصة بجيش جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ولعله من المثير أن تنادي دول أوروبية أخرى كانت ضحية لألمانيا قبل سبعة عقود، بإعادة تسليح الجيش الألماني، فعلى سبيل المثال تحدث وزير خارجية بولندا عام 2011 بقوله “إن تخوفي من عدم تحرك ألمانيا، أكثر من تخوفي من قوتها”، وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على أن العديد من دول أوروبا الشرقية تتمنى أن يكون هناك جيش ألماني قوي لا يتردد في الدفاع عن الحلفاء، الأمر الذي أسهمت الأزمة الأوكرانية في تعزيزه، واعتبار الجيش الألماني ركيزة أساسية ضمن ركائز الأمن الأوروبي.
والثابت أن فرنسا لم تعد خائفة من حضور جيش ألماني قوي، وهذا ما يعبر عنه المحلل السياسي والباحث في جامعة السوربون هانز شتارك بقوله “إن فرنسا تريد مشاركة ألمانيا في المهام العسكرية في أفريقيا وفي الشرق الأوسط”، ويشمل ذلك مهمات قتالية و”إرسال قوات برية وليس قوات حفظ سلام فقط”.
يقول شتارك، إن فرنسا لا تتخوف من الجيش الألماني ولا ترى فيه تهديداً، لأنها تعتبر أن جيشها أقوى من نظيره الألماني.
هل أدرك الأوروبيون الآن الخطأ الكبير في أن تستمر ألمانيا قلباً اقتصادياً للقارة الأوروبية من غير قوة عسكرية تتحمل جزءاً يليق بها من الأعباء الأمنية في القارة التي باتت تتهددها المخاطر.
ولعله من نافلة القول إن الاتحاد الأوروبي اليوم يشعر برغبة كبيرة في أن تقوم ألمانيا بدور عسكري، لا سيما بعد انسحاب بريطانيا التي تمثل الثقل الأكبر أوروبياً على صعيد العسكرة، ولا يتبقى سوى التساؤل: هل واشنطن تقف حجر عثرة أمام ألمانيا أم العكس؟
أميركا ـ ألمانيا… هل من مخاوف أمنية؟
لا يبدو الجواب واضحاً وضوحاً كافياً، ذلك أن واشنطن وإن لم تظهر رفضاً واضحاً، إلا أنه تبقى لديها شكوك ما تجاه الرؤية الألمانية للقوة، فلسفياً أول الأمر، وصولاً إلى التطبيق على الأرض تالياً.
ولعل خير دليل على مخاوف واشنطن مما يحدث في الداخل الألماني عسكرياً، زرعها جواسيس داخل وزارة الدفاع الألمانية، ووصل الأمر إلى حد التجسس على هاتف المستشارة الألمانية السابقة ميركل، عبر برنامج “بريزم” قبل بضعة أعوام، الأمر الذي تسبب في إشكالية دبلوماسية بين البلدين الحليفين في “الناتو”.
هل تخشى واشنطن من وصول الجماعات اليمينية المتطرفة من أمثال حزب “البديل من أجل ألمانيا” وحركة “بغيدا” وبقية الإفرازات المشابهة إلى الحكم، وساعتها سيكون تسليح الجيش الألماني كارثة على أوروبا أول الأمر وعلى “الناتو” لاحقاً؟
لبضع سنوات خلت والشكوك تدور داخل الرؤوس الأميركية تجاه الصحوة الألمانية، وربما لهذا تعنتت أميركا طويلاً في إعادة رصيد الذهب الاحتياطي الألماني المحتفظ به منذ عقود لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، وما بين التجسس الاستخباراتي وقضية الذهب، تبدو واشنطن قلقة من التغيرات والتحولات “الجيو بوليتيكية” العالمية وألمانيا في مقدمها.
غير أنه من الواضح وأمام التحركات الروسية في الأعوام الأخيرة، أن واشنطن تختار الأمر الأقل ضرراً، بمعنى أنها توافق على زيادة عسكرة المشهد الألماني، ليكون درعاً وسيفاً لأوروبا في مواجهة روسيا.
في هذا السياق، يمكن القطع بأن فترة ولاية الرئيس ترمب اليتيمة، زخّمت هذا الاتجاه، ومن قبلها بعام، حين طالب وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015، الحكومة الألمانية بزيادة نفقاتها العسكرية، التي كانت قد توقفت عند حدود أقل من 1.2 في المئة من إجمالي الناتج القومي، في حين تنص وثائق حلف “الناتو” على ضرورة تخصيص اثنين في المئة من إجمالي الناتج القومي لميزانية الدفاع.
يمكن القول إن واشنطن ومهما كانت هواجسها، فإنها قد خلصت أخيراً إلى أن الأزمات الدولية، وما ينتظر الأمن الأوروبي ومنظومته، تحتاج إلى صحوة من قبل الجيش الألماني، وإن بقي السؤال هل يمكن أن يسمح لألمانيا أن تضحى دولة نووية كما الحال مع فرنسا وبريطانيا؟
من يقبل ألمانيا كدولة نووية أوروبية؟
أطلقت صافرات إنذار الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا المخاوف عند الألمان، وأثار الأمر انتباههم بأن عليهم إعادة التموضع العسكري، وبما يتناسب مع الدور الذي تلعبه اقتصادياً في الداخل الأوروبي أولاً، وعالمياً تالياً.
على أن شأن تحديث الجيش الألماني بات يتقاطع مع جزئية مثيرة للجدل بعينها تتمثل في الطموحات النووية الألمانية وهل يسمح لألمانيا بأن تمتلك سلاحاً نووياً أم لا؟
قبل أربعة أعوام، وبالتحديد في يوليو (تموز) من عام 2018، دعا عالم السياسة الألماني الشهير، كريستيان هاكه، في مقال له نشر عبر صحيفة “فيلت أم زونتاغ”، إلى أنه يتوجب على ألمانيا التصرف للمرة الأولى منذ عام 1949 من دون درع حماية نووية من جانب الولايات المتحدة.
والمعروف أن أميركا تخزن العديد من الرؤوس النووية على الأراضي الألمانية، غير أن ذلك لم يعد مقبولاً من كثير من الألمان، وعند هاكه أن “ألمانيا تعد في حالة أزمة شديدة اليوم بلا حماية، ولهذا لا بد لها من التفكير والتصرف بشكل موجه نحو المستقبل، كي يمكن ردع أي هجوم محتمل نووياً”.
هل تحتاج ألمانيا إلى جهود كبيرة للحصول على سلاحها النووي؟
المعروف أن علاقة ألمانيا بالبرامج النووية قد بدأت مبكراً منذ عام 1939، وعلى الرغم من كل الانكسارات التي تعرضت لها، فإنها كانت من الذكاء في أمرين:
الأول: حفاظها على القدرات العلمية اللازمة للوصول إلى اليورانيوم المخصب، التي تحتفظ به بالفعل.
الثاني: قدرتها على تحويل كل برامجها الصناعية المدنية، إلى صناعات عسكرية، ومنها النووي خلال ستة أشهر على أقصى تقدير.
وفي كل الأحوال، قد لا تكون فكرة ألمانيا نووية فكرة مقبولة لكثيرين في الوقت الراهن، إلا أنه من دون أدنى شك، سيظل أثر تهديدات فلاديمير بوتين عبر ترسانته النووية لأوروبا وأميركا، قائماً وقادماً في أذهان الألمان، ويوسوس في آذانهم لجهة حيازة سلاحهم النووي، ومن غير الارتكان إلى البديل الأميركي.
ومن الواضح أن أوروبا وأميركا قد أدركتا أنهما وكما ساعدتا ألمانيا على النهوض اقتصادياً بعد الحرب العالمية الثانية، كان عليهما أيضاً عدم حرمانها من بناء جيش قوي يكون قادراً على لعب دور فاعل في حماية أوروبا.
———————————-
6 سيناريوهات محتملة… كيف ستنتهي حرب بوتين في أوكرانيا؟
منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، والعالم يحبس أنفاسه. فإلى جانب التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية على طرفي المواجهة، فإن قذيفة واحدة تضل طريقها أو قراراً يتم اتخاذه دون حساب تداعياته كفيل بإطلاق شرارة حرب عالمية ثالثة تتطاير شظاياها في كل مكان.
وحتى لا ينفرط عقد الأمور، وعلى وقع دوي الانفجارات وإطلاق العقوبات، تتواصل الجهود من مختلف الأطراف، لعلها تسفر عن وقف قريب لنزيف الدماء والأموال. إلا أنه لا أحد يعرف حتى الآن كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب، ولا تزال معظم السيناريوهات المتداولة تتراوح بين السيئ والأسوأ.
واستعرض الكاتب أندرياس كلوث، في مقال رأي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بعض السيناريوهات المطروحة:
– الأوكرانيون ينتصرون
يدور هذا السيناريو حول استبسال الأوكرانيين في الدفاع بحيث يتمكنون من صد القوات الروسية، وهو أمر مستبعد من وجهة النظر العسكرية، لكنه بالطبع النتيجة المفضلة لمعظم دول العالم. فأوكرانيا الجريحة المنتصرة ستتكامل مع الاتحاد الأوروبي المتماسك والحازم، وسيتسارع اندماجها في الغرب الديمقراطي. وسيصبح لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوة محركة جديدة.
وستفكر الصين مرتين قبل أن تتسبب في مشكلات لتايوان.
إلا أن مثل هذا السيناريو سيضع بوتين في الزاوية؛ فهو لطالما أظهر نفسه المحارب الروسي ضد الغرب العدواني، والمنقذ للمنحدرين من أعراق روسية ومن إثنية السلاف (الهندوأوروبية) في كل مكان. وبطبيعة الحال، فإن انتصار أوكرانيا سيجعله غير قادر على النجاة بنفسه من الهزيمة سياسياً. ولأنه يدرك ذلك، فإنه لن يسمح بحدوث هذا السيناريو. وبدلاً من الانسحاب، سيضغط لحدوث واحد من ثلاث مسارات أخرى.
– إمبراطورية منبوذة
يمكن أن يقوم بوتين بتصعيد الهجوم بشكل كبير، ولكن مع استمرار استخدام الأسلحة التقليدية. ويعني هذا في الأساس مواصلة قصف أوكرانيا حتى إجبارها على الخضوع. وستكون الخسائر مرعبة في صفوف المدنيين والعسكريين، إلا أن بوتين لن يكترث. وسيضم أوكرانيا المضطربة والمستاءة – إما كدولة دمية باسم مستقل أو كتابع لـ«روسيا العظمى».
ولقمع معارضيه في الداخل وفي أوكرانيا، سيتعين على بوتين المضي في تحويل روسيا لدولة أمنية، والقضاء على ما تبقى من حرية تعبير. وستظل إمبراطوريته منبوذة بشكل دائم في المجتمع الدولي.
– أفغانستان جديدة
وربما يختار بوتين التصعيد بشكل أقل دراماتيكية، بحيث يرسل قوة عسكرية روسية إلى أوكرانيا تكفي لعدم إعلان هزيمة صريحة له. وفي هذه الحالة، يمكن أن تصبح البلاد بعد ذلك كما كانت أفغانستان للزعيم السوفياتي ليونيد بريغينيف بعد عام 1979، أو أن تصبح مستنقعاً كما كانت للولايات المتحدة وحلفائها بعد 2001.
وفي السيناريو الأفغاني، ستكون التكلفة البشرية مروعة – بالنسبة للأوكرانيين بشكل خاص، وكذلك للروس العسكريين والمدنيين الذين سيعانون من قسوة القمع وشدة العقوبات. ولن يأبه بوتين لكل ذلك، ما دام مكانه في الكرملين آمناً.
– ضربة نووية محدودة
في هذا السيناريو، سيتذرع بوتين بمحاصرة الناتو والاتحاد الأوروبي له من خلال دعم أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من الوسائل، ويمكنه شن واحدة أو أكثر من الضربات النووية «المحدودة» بما يسمى بالرؤوس الحربية التكتيكية (أي منخفضة القوة).
وسيراهن بوتين هذه المرة على أن الغرب لن ينتقم نيابة عن أوكرانيا؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تبادل إطلاق نار نووي بأسلحة «استراتيجية» أكبر، وينتهي بـ«التدمير المتبادل المؤكد».
ولن يبقى أمام أوكرانيا، كما كان الحال لليابان في عام 1945، خيار سوى الاستسلام. ولهذا السبب يطلق العسكريون المحنكون على هذه الاستراتيجية اسم «التصعيد من أجل خفض التصعيد». ولكن العالم بعدها لن يكون كما كان.
وستنضم إلى هيروشيما وناجازاكي أسماء مدن أخرى على قائمة خزي البشرية.
ولكن بوتين سيرى أنه أخرج نفسه من موقف محرج.
– ثورة روسية أخرى
يقول كلوث، إنه على جانب آخر، هناك سيناريوهات أكثر تفاؤلاً، وإنه رغم ستار الدعاية والتضليل الذي ينشره بوتين، يدرك عدد كافٍ من الروس ظروف غزوه غير المبرر ومخاطره المأساوية. وهؤلاء يمكنهم أن يثوروا. وقد تتخذ مثل هذه الثورة شكل حركة واسعة النطاق تدار من الخارج وتتمحور حول زعيم معارض مثل أليكسي نافالني، أو قد يكون انقلاباً، أو انتفاضة داخل النخبة.
ورأى كلوث أن أياً من هذه الصور للتمرد غير واردة في الوقت الراهن. ومع ذلك، فقد لفت إلى أن اندلاع ثورة محلية في روسيا سيكون أفضل نتيجة إلى حد بعيد. فالنظام الجديد في موسكو يمكن أن يُحمّل بوتين وحده المسؤولية، وهو أمر صحيح في الواقع. وحينها يمكن لهذا النظام أن ينسحب من حرب أوكرانيا دون أن يبدو ضعيفاً، وسيرحب المجتمع الدولي بعودة روسيا بأذرع مفتوحة. وسيصبح العالم، بما في ذلك روسيا، مكاناً أفضل.
– تدخل صيني
واعتبر الكاتب أن ثاني أفضل سيناريو والأكثر منطقية يتعلق ببكين. ورسمياً، فإن الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ ترى نفسها، إن لم تكن حليفاً لروسيا، فهي على الأقل شريك لها في الصمود في وجه الغرب بقيادة الولايات المتحدة.ولكن في الوقت نفسه، ترى الصين نفسها قوة صاعدة بينما روسيا قوة آفلة. ويرى شي أن بوتين قد يكون مفيداً في بعض الأحيان، ولكن العلاقات معه تمثل أيضاً عبئاً محتملاً.
ويختتم كلوث مقاله بأنه إذا ما قررت الصين تكبيل يد بوتين، فإنها ستستفيد بلا شك. وهي في الواقع قادرة على سحب أطواق النجاة الاقتصادية والدبلوماسية التي تحتاج إليها موسكو.
————————–
رغم الهدوء الظاهري… في جنوب غرب أوكرانيا «لا شيء على ما يرام»/ فداء عيتاني
قد يبدو للزائر أن كل شيء على حاله في باريس الصغيرة، مدينة شيرنفستسي، جنوب غربي أوكرانيا، إلا أن من يعبر الحدود الرومانية الأوكرانية أو يتجول مساءً في المدينة الصغيرة، أو يلتقي بأبناء المدينة ومتطوعي «الدفاع الوطني» يعلم أن المدينة لم تعد على حالها، حتى لو شاهدت شاباً يقبل فتاة في الشارع، أو امرأة تنزه كلبها على الطريق العام.
يمكن أن تلحظ تبدلاً في نمط الحياة لحظة صعود الطائرة المتوجهة من أحد مطارات لندن نحو مطار ستشافا (شمال رومانيا على مبعدة 35 كلم من الحدود الأوكرانية)، لم تعد رحلة الطيران المباشرة تنقل عمالاً وموظفين روماناً يعملون في بريطانيا، بل أضيف إليهم عدد من الأوكران، الذين تقطعت بهم السبل نحو وطنهم.
إيفان سوروشان (32 عاماً) هو أحد هؤلاء، أوكراني يعمل ويعيش في لندن منذ 15 عاماً، أحد أبناء المناطق الحدودية المتخمة لرومانيا، ابنته نيسا (13 عاماً) كانت حتى اليوم تعيش في شيرنفستسي، ولكن إيفان قرر إخراجها مؤقتاً نحو إيطاليا إلى أن يستكمل إجراءات لجوئها في بريطانيا.
إلا أن انشغال إيفان بمهمة إنقاذ ابنته لم يمنعه من مد يد العون لصحافي يريد الدخول إلى أوكرانيا، إيفان قطع الحدود التقى ابنته، أصر على تعارف سريع مع الصحافي القادم من بريطانيا وعاد، ساعات قليلة واتصل ليقول إنه في رومانيا ويسأل عما يمكنه أن يقدم كمساعدة لإيجاد مسكن في المدينة الأوكرانية.
في رومانيا نحو الحدود الاوكرانية
إيفان ليس وحده من يعرض المساعدة، رغم غرابة وضع المطار الصغير جداً في شيرنفستسي الرومانية، وشبهه بمحطة باصات صغيرة، فإن موظف الأمن العام الحدودي يسأل إن كان القادم من بريطانيا متأكداً بأنه ليس بحاجة لفيزا، ثم يجيب بصبر عن أسئلة حول الانتقال إلى أوكرانيا وطول المسافة وإمكانية العثور على تاكسي.
الحدود الرومانية
على امتداد 3 كيلومترات قبل الوصول لنقطة الجمارك الحدودية الرومانية امتدت على جانبي الطريق خيم لكل الجمعيات الإغاثية، الشرطي الروماني، الذي يتحدث الإنجليزية بتلقائية يطلب من الجميع الترجل من سياراتهم والصعود في باصات صغيرة لمتطوعين لنقلهم نحو الجمارك الرومانية. المتطوعون من مختلف الجمعيات يعرضون كل أنواع المساعدات العينية للآتين للتو من أوكرانيا، الطعام والشراب الساخن أو الماء، الثياب ومستلزمات الأطفال، على هذا الجانب من الحدود لا يوجد نقص، ثمة من سيتولى مساعدة الآتين، حتى رجال الدين المسيحيون الأرثوذكس نصبوا خيمتهم ووقفوا يعرضون مد يد العون لعابري الحدود.
لن تفهم بالضبط سبب هذا الاستنفار للجمعيات الأهلية خصوصاً أن عدد الموجودين قرب الخيم ممن تبدو عليهم الحاجة لا يتجاوز بضع مئات، وهم يتحركون بالباصات إجمالاً نحو مناطق رومانية قريبة، أو نحو دول أوروبية وصولاً إلى إيطاليا، وسائقو الباصات هنا يعرضون تسعيرة لا تتجاوز ثمن المحروقات لنقل العائلات نحو وجهات متعددة: رومانيا، بولندا، هنغاريا، إيطاليا، أو حتى فرنسا. إذاً لماذا هذا الاستنفار؟
قبل أن نصل إلى الحدود من ناحية أوكرانيا، نقف على نقطة الحدود الأخيرة لرومانيا، الجندي يحتج بشدة: «بريطانيا لم تعد في أوروبا، كيف أدخلوك إلى البلد؟ وكيف تريدني أن أخرجك من رومانيا؟ أنتم لستم أوروبيين». بعد نقاش قصير يقتنع الجندي الحدودي بأن يختم جواز السفر، بينما يتطوع سائق حافلة أوكراني لا يعرف أي كلمة باللغة الإنجليزية بنقل الزائر إلى داخل أوكرانيا. اللغة العالمية للإشارات تحتل حيز التفاهم هنا. ويبعد بشدة اليد الممتدة بالمال رافضاً تقاضي أي مقابل.
ما أن نصل إلى الجانب الأوكراني للحدود حتى يتضح سر استنفار الجمعيات الأهلية على الجانب الروماني، آلاف من اللاجئين الأوكران يصطفون في طوابير راجلة طويلة بانتظار خروجهم من البلاد المنكوبة، النساء والأطفال والعجزة لهم الأولوية، بينما اتخذت الحكومة الأوكرانية قراراً بالتحفظ على إخراج الذكور من عمر 16 وحتى 60 ما عدا حالات خاصة.
آلاف العابرين ينتظرون دورهم ليصبحوا لاجئين، وتنتظرهم الجمعيات على الجانب الآخر بالمساعدة الممكنة، سينتظر كل عابر بما معدله أربع إلى خمس ساعات قبل أن يتمكن من الوصول إلى الجانب الروماني، بينما العربات الآلية قد تنتظر ليومين أو أكثر.
الشارع الرئيسي في المدينة: باريس الصغيرة وممر النازحين نحو رومانيا
لا، للأسف، الأمور ليست على خير ما يرام على الجبهة الغربية الجنوبية إذاً. والمدينة الصغيرة التي كانت هادئة ومتفاخرة بأن مبنى جامعتها على لائحة الأونيسكو للأماكن الأثرية قد أصبحت تغص بالنازحين.
لا غرف ولا إنجليزية
ما أن ترى قادماً جديداً تقول عاملة الاستقبال في الفندق بالإنجليزية: «لا غرف». مهما تحاول الشرح فإن الجواب نفسه، الحجز الإلكتروني لا يعني شيئاً: «هناك آلاف النازحين من كل أوكرانيا، لم يعد لدينا غرف».
ما تشعر به من خيبة لا يقارن بما ستشعر به حين تحاول في فنادق أخرى، حيث لن تجد من يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية، ولكن رجلاً عجوزاً عاش وعمل في أميركا اللاتينية يجيد الإسبانية يحاول القيام بمهمة الترجمة، ويحاول أيضاً أن يخبرك سائق سيارة تاكسي ليدور بك على الفنادق، ثم يساهم مترجم غوغل الآلي في التواصل، وتحار عاملة استقبال في كيفية إفهامك بأن ليس لديها غرف، ولم يساعد هنا لا غوغل ولا ترجمته الفورية، فتخرج قليلاً لتعود برفقة شاب وزوجته، يسألك الشاب عما أتى بك إلى أوكرانيا.
بلى يقول الشاب، نحن نتحدث الإنجليزية ولكن الأغلبية العظمى لم تتح لها إمكانية التعليم الجامعي. ألكسندر كرشوشينكو (32 عاماً) من كييف، أتى ليخرج زوجته نحو رومانيا، ويعود بعدها إلى أي مكان يحتاج لمتطوعين. ألكسندر سيعطيك رقم ألكسندر آخر هو مدير العمليات في الدفاع الوطني في المدينة، وكلاهما صديقان ويعملان في مجال البرمجة والمعلوماتية، وكانا على علاقة عمل مع شركات روسية، ويسافران بانتظام نحو موسكو، إلى أن بدأت الحرب.
ألكسندر، مدير عمليات الدفاع الوطني يدعوك إلى مطعم. تعال وسنتحدث بكل شيء. الطرق بدأت تقفر، الساعة لم تتجاوز الثامنة، نزهة الكلاب بدأت تنتهي هنا في باريس الصغيرة، لا تزال العمارة الجميلة والإضاءة الموزعة في المدينة تشير إلى الجمال والعراقة في هذه الأنحاء من البلاد. خرائط غوغل تقول إن كل المحال مغلقة، بما فيها المكان الذي دعاك إليه ألكسندر. ولكن ألكسندر يصر عبر الهاتف بأن تأتي.
لا ينفع أن تحاول الاسترشاد من المارة عن الطريق، لا أحد يجيد الإنجليزية، حين تعثر على شخص سيسألك بريبة هل تسكن في هذا العنوان؟ وحين يعلم أنه لديك صديقاً هناك يرشدك إلى مدخل لا يبعد أكثر من خطوات، الشاب نفسه من ضمن المتطوعين، وفي المطعم يجلس ألكسندر ومجموعة من الشبان والشابات، وهو متطوعون أكبرهم في الأربعين، يدخنون الشيشة رغم أن التدخين في المطاعم ممنوع، ولكن المطعم مغلق أمام الزبائن، وهو جزء من حياة المتطوعين الجديدة.
نيسا، فتاة عشرينية، تجيد الإنجليزية بطلاقة، تسأل وتسأل، ثم تقول كنا نختبر ما تعلمه عنا، تضحك، ثم تقول نحن في ورطة كبيرة، ولكن لا يمكن أن نخسر.
ألكسندر يقول ثمة مكان لك الليلة، وحين تريد مغادرة المدينة سنساعدك. ولكن لدينا 25 ألف نازح، كثر يغادرون إلا أن غيرهم يستمر بالتدفق. يصل ديما شاب عشريني هو الآخر يملك محلاً تجارياً لبيع أدوات التخييم، تحول إلى ملجأ للنازحين، نيسا تقول هذا هو رجلك. ستبيت الليلة عنده، يستمر الشبان بالحديث، بينما ديما يدعوك لمرافقته.
ديما في متجره السابق – الملجأ الحالي لأكثر من ١٥ نازح ونازحة
شوارع المدينة بدأت تشهد حركة لسيارات الشرطة، حظر التجول سيحل بعد قليل. المحل الذي كان يوماً لأدوات التخييم أصبح يحوي فرشاً إسفنجية وكنبات متهالكة للنوم. تمارا (85 عاماً) وابنها ديمتري وزوجته وابنهما مادي (14 عاماً) أتوا من كييف، الطريق استغرق وقتاً طويلاً لأن ديمتري كان يفضل البقاء قرب العاصمة، عسى أن تتوقف المعارك، ولكن اليوم قرر أن يرحل ابنه وزوجته إلى رومانيا، بينما والدته قررت البقاء معه. «غداً قد ننتقل إلى سكن طلابي جامعي، والدتي وأنا، ولا أعرف ما الذي سأفعله بعدها» يقول ديمتري.
ديما صاحب المحل التجاري سابقاً، والمتطوع في الدفاع الوطني حالياً يترك المقر المستحدث للاجئين دون أن ينسى أن يحضر كل الحاجيات الأساسية للسكان الجدد، الشاي والقهوة والطعام. بينما ديمتري ينشغل بالترجمة لوالدته كيف يمكن أن يأتي شخص من بريطانيا إلى أوكرانيا في حالة الحرب.
توقفه والدته تمارا عن الكلام، تطلق بعض الكلمات، يمكن أن تميز بينها اسم بوتين، وحين تصر على ديمتري للقيام بالترجمة يكتفي بالقول «وصفت بوتين بكلمات سيئة».
العاشرة ليلاً، الكثير من الصور المحيطة تقول إن الحياة هنا ليست هادئة أبداً، سيارات الشرطة تتجول في المدينة، ديمتري يغلق البوابة الحديدية للمحل التجاري السابق والملجأ الحالي، حظر التجول بدأ، لا تدخين في الخارج بعد. أوكرانيا ليست بخير.
الشرق الأوسط
————————-
توماس فريدمان: بثلاثة أسلحة خطيرة.. محو روسيا الأم يجري على قدم وساق
كل يوم يمر تصبح فيه الحرب في أوكرانيا مأساة كبرى للشعب الأوكراني ولكنها أيضا تشكل تهديدًا أكبر لمستقبل أوروبا والعالم بأسره، فهل من سبيل إلى إنهائها؟
للرد على هذا السؤال، أكد الكاتب الأميركي المخضرم توماس فريدمان أن الجهة الواحدة القادرة على إيقاف هذه الحرب فورا ليست الولايات المتحدة، وإنما هي الصين.
وحاول فريدمان في مقاله بصحيفة “نيويورك تايمز” (New York times) تقديم مبررات يرى أنها كافية لجعل الصين تقوم بدور محوري لإنهاء هذه الحرب.
واعتبر فريدمان أن الصين إذا انضمت، بدلاً من البقاء على الحياد، إلى المقاطعة الاقتصادية لروسيا أو حتى لو أدانت بشدة هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا وطالبتها بالانسحاب، فإن من شأن ذلك أن يهز كيان الرئيس فلاديمير بوتين بما يكفي لوقف هذه الحرب الشرسة، أو على الأقل سيجعله ذلك يتوقف مؤقتًا، إذ لا يوجد لديه حليف مهم آخر في العالم الآن غير الهند.
وتساءل فريدمان “لماذا ينبغي للرئيس الصيني شي جين بينغ اتخاذ هذا الموقف، والذي يبدو وكأنه يقوض حلمه بالاستيلاء على تايوان بالطريقة نفسها التي يحاول بها بوتين الاستيلاء على أوكرانيا؟
والإجابة المختصرة على هذا السؤال، يقول فريدمان، هي أن العقود الثمانية الماضية من السلام النسبي بين القوى العظمى أدت إلى عالم يتحول بسرعة إلى عولمة مثلت مفتاح النهوض الاقتصادي السريع للصين وبالتالي انتشلت ما يقرب من 800 مليون صيني من الفقر منذ عام 1980.
وأضاف أن السلام كان جيدا جدا للصين، التي يعتمد نموها المستمر على قدرتها على التصدير إلى هذا العالم الذي يتسم بالاندماج والتحديث المستمر للأسواق الحرة وقدرتها على التعلم منه.
وأكد فريدمان أن تحسن المستوى الاقتصادي للصينيين بشكل مطرد يعتمد إلى حد كبير على استقرار الاقتصاد العالمي ونظام التجارة.
وحذر الكاتب الإستراتيجيين الصينيين المنغمسين في التفكير القديم القائم على الجزم بأن أي حرب تضعف الخصمين الرئيسيين للصين الحديثة، أميركا وروسيا، يجب أن تكون شيئا جيدًا، قائلا إن كل حرب تجلب معها طرقا جديدة للقتال والبقاء على قيد الحياة، والحرب في أوكرانيا لن تكون استثناء، حسب قوله.
ولفت إلى أن 3 “أسلحة” تم نشرها في هذه الحرب بطرق لم نشهدها من قبل أو لم نشهدها منذ أمد بعيد، وسيكون من الحكمة أن تدرس الصين كل هذه الوسائل.
وأضاف أن الصين إذا لم تساعد في إيقاف روسيا الآن، فإن هذه الأسلحة إما ستدفع بوتين في النهاية إلى الخضوع مما يعني أنه قد يتم استخدامها ضد الصين يومًا ما إذا استولت على تايوان، وإما تلحق الضرر بموسكو بشدة لدرجة أن الآثار الاقتصادية ستكتسح كل شيء في روسيا، وقد تدفع هذه الأسلحة بوتين إلى فعل ما لا يمكن تصوره بأسلحته النووية، مما قد يزعزع الاستقرار، بل يدمر الأسس العالمية التي يرتكز عليها مستقبل الصين.
3 ابتكارات
وأهم ابتكار في هذه الحرب، وفقا للكاتب، هو استخدام المكافئ الاقتصادي للقنبلة النووية، التي يتم نشرها في الوقت نفسه من قبل قوة عظمى ومن قبل أشخاص لهم قدرات خارقة.
وأوضح ذلك بالقول إن الولايات المتحدة فرضت، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على روسيا من شأنها أن تشل اقتصادها، وتهدد الشركات الروسية بشدة، وتحطم مدخرات ملايين الروس بسرعة ونطاق غير مسبوقين يجعل الشخص يستحضر مفعول الانفجار النووي.
وأضاف أن بوتين اكتشف ذلك الآن، وقال صراحة يوم السبت الماضي إن هذه العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي “أشبه بإعلان حرب”، وهو ما علق فريدمان عليه بالقول “فلاديمير (بوتين) لم تتحمل نصف العبء بعد”.
أما الابتكار الثاني فقال عنه فريدمان: نظرًا لكون العالم أصبح الآن كله مرتبطا عبر وسائل التواصل الحديثة بشكل وثيق، فإن ذلك أعطى للأفراد والشركات ومجموعات الناشطين الاجتماعيين القدرة على تكثيف عقوباتهم ومقاطعاتهم، دون أي أوامر حكومية، مما يضخم العزلة والاختناق الاقتصادي لروسيا بما يتجاوز ما قد تفعله الدول القومية، فهذه الجهات الفاعلة الجديدة -وهي نوع من حركة المقاومة والتضامن العالمية المؤيدة لأوكرانيا- تعزل بشكل جماعي بوتين وروسيا، ونادرًا ما يكون هناك بلد بهذه الضخامة والقوة يتم محوه سياسيًا وإصابته بالشلل الاقتصادي بهذه السرعة.
أما السلاح الثالث، حسب فريدمان، فهو جديد وقديم، وهو روحاني وعاطفي، إذ جعلت هذه الحرب الغرب يكتشف نفسه من جديد، لقد أيقظ انقضاض الروس على أوكرانيا الغرب، و”يمكن لأميركا والمجتمعات الليبرالية بشكل عام أن تبدو وتتصرف بغباء ومنقسمة لكن يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها، و”اسأل أدولف هتلر”، يقول فريدمان.
ويجب أن تمثل هذه الأسلحة عبرةً للصين، وفقا للكاتب، خصوصا أنها ترى ما حلّ بروسيا وقطاعها المالي ومصارفها، وضرب الكاتب مثالا صارخا على تدمير القيمة السوقية المذهل للمؤسسات الروسية المالية ما حلّ بأسهم مصرف “سبيربنك” (Sberbank)، أكبر بنك في روسيا، “انهارت بأكثر من 99% منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، عندما تم تداول سهمه عند حوالي 14 دولارًا، ويوم الأربعاء الماضي في تداولات لندن انخفض سهمه حتى وصل سنتا واحدا”.
وشدد على أن روسيا والروس يُستبعدون الآن من كل شيء، فطيرانهم متوقف ولا يسمح لهم بالمشاركة في منافسات الألعاب الدولية، هذا فضلا عن حملات الإنترنت الشديدة التي يشنها قراصنة وغيرهم من مؤثري الشبكات الاجتماعية للإضرار بروسيا، وهؤلاء لا يخضعون لأي جهة معينة وحتى لو توقف إطلاق النار من خلال صفقة معينة، فهؤلاء لا وصاية لأحد عليهم.
واستنتج فريدمان مما سبق أن بوتين كان جاهلاً تمامًا بالعالم الذي كان يعيش فيه، ولذا راهن رهانا خاسرا لم يأخذ في الاعتبار القواعد الخاصة بكازينو العولمة للقرن الـ21.
وهناك دلائل، وفقا لفريدمان، على أن الصين تدرك بعض هذه الحقائق الجديدة، وأنه لا يوجد بلد أكبر من أن يتم عزله في هذا العالم شديد التشابك عبر الإنترنت، لكن يبدو أن غريزتها الأولية هي محاولة عزل نفسها عن هذا الواقع، بدلاً من التصعيد للمساعدة في عكس عدوان بوتين، وهو ما حذر منه فريدمان قائلا إن الصين ليست محصنة من أن تلقى المصير نفسه.
وختم الكاتب بالقول إنه يأمل أن تنضم بكين بدلا من التقوقع على نفسها للغرب وجزء كبير من العالم في معارضة بوتين، وستظهر الصين، إن هي فعلت ذلك، كزعيم عالمي حقيقي، أما إذا اختارت بدلاً من ذلك الركوب مع الخارجين عن القانون، فسيكون العالم أقل استقرارًا وأقل ازدهارًا بشكل لا يمكن تصور مداه، وخاصة الصين، على حد تعبيره.
المصدر : نيويورك تايمز
—————————-
لوفيغارو: سوريا مختبر الهمجية في حروب بوتين.. واسمعي يا أوكرانيا
قالت “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسية إنه في اليوم الثامن من الحرب على أوكرانيا، عندما قصفت روسيا المدارس ومراكز الطوارئ ودمرت المناطق السكنية، أيقظت لدى السوريين مرارة المناظر المستعادة في حلب وإدلب والغوطة، وتصاعدت أصواتهم للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا والتنديد بعنف موسكو، التي يتهمونها بجعل بلادهم مختبرا لتجريب ترسانتها العسكرية والتدرب على دعايتها دون عقاب.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن التضامن الذي يظهره السوريون تجاه الأوكرانيين لا يأتي فقط من تجربة مشتركة للاحتلال العسكري الروسي، بل يأتي كذلك من إدراكهم المتزايد أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة لما سمح العالم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفعله في سوريا، كما يقول المدافع السوري عن حقوق الإنسان مروان سفر جلاني على صفحته على تويتر.
وذكرت الصحيفة -في تقرير لمراسلها في إسطنبول دلفين مينوي- أن روسيا عندما دخلت في الصراع السوري عام 2013، بعد عامين من الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد، كانت تهدف بعد اتفاق مع واشنطن إلى الإشراف على تفكيك الأسلحة الكيميائية في دمشق، ولكن استعراض السفن الحربية الروسية التي تعبر مضيق البوسفور إلى قاعدتها في طرطوس كان يشير إلى أن موسكو لديها أفكار أخرى.
وبعد ذلك بعامين، عندما أضفى بوتين الطابع الرسمي على تدخله العسكري إلى جانب الجيش السوري، مدعيا أنه يريد محاربة تنظيم الدولة الإسلامية -كما يقول المراسل- بدا مرة أخرى أن نواياه مختلفة تماما، ليتضح أن سيد الكرملين، الذي ينوي تأمين وصول بلاده إلى البحر الأبيض المتوسط، قد شرع بلا ضمير في حملة عسكرية للقضاء على جميع أشكال المعارضة المعتدلة لسلطة دمشق، متجاوزا كل الخطوط الحمر التي سبق أن أقرتها واشنطن.
تحت نيران القوات الجوية
وكانت حلب، تلك المدينة التي انقسمت عام 2016 إلى جزءين، شرقي في يد المعارضة وغربي تحت سيطرة نظام بشار الأسد، هي المثال المأساوي -كما يرى الكاتب- على وحشية الروس، عندما تعرضت الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة للحصار والقصف بلا هوادة لمدة 3 أشهر، دون أي تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وحينها، أطلق العنان لطائرات “سوخوي 24” (Sukhoi 24) لتحلق في السماء بلا هوادة، مطلقة نيرانها على القوافل الإنسانية والأسواق والمدارس والمباني السكنية، في تنفيذ -وفق الكاتب- لسياسة الأرض المحروقة التي مارسها الروس في غروزني عام 1999، والتي تعرضت خلالها المستشفيات بشكل متعمد للقنابل العنقودية، تماما كتلك التي ألقيت على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
وينقل الكاتب عن الطبيب زاهر سحلول عبر الهاتف أن “المأساة الأوكرانية مألوفة بشكل رهيب بالنسبة لنا. فبعد أن اختبر بوتين أسلحة جديدة في سوريا ضد السكان المدنيين، أعاد إنتاج النمط نفسه من خلال إفراغ المدن من سكانها وحصارهم، في تكتيك ضار، به يخلق موجات من اللاجئين في أوروبا تغذي أقصى اليمين، وتؤدي إلى استقطاب المجتمعات وزرع الفوضى بعيدا عن بلده”.
شهادة بجرائم حرب
ويتحدث الطبيب السوري المقيم في شيكاغو عن سابق معرفة، بعد أن عمل -أثناء مهامه المتعددة في سوريا منذ بداية الحرب- في مستشفيات تعرضت للقصف، وكان شاهدا على جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد وحليفه الروسي، حيث تقول منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن نحو 600 مركز طبي تعرضت للهجوم خلال الحرب في سوريا، 40% منها بعد التدخل الروسي عام 2015، وقتل فيها ما لا يقل عن 930 طبيبا وممرضا.
وأشار الكاتب إلى أن كل هذا تم الإبلاغ عنه بدقة، ولكن عدم اهتمام الغرب شجّع بوتين على الاستمرار في وتيرته وجعل الأرض السورية قاعدة تدريب لصراعات أخرى، وهو ما لا تخفيه موسكو، إذ يقدر مقطع فيديو صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن عدد الجنود “المدربين على القتال” يزيد عن 63 ألف جندي في سوريا، كما يفتخر وزير الدفاع سيرجي شويغو بأنه اختبر أكثر من 320 نوعا من الأسلحة هناك.
وبحسب الكاتب، فإذا كان لدى الطبيب زاهر سحلول أي نصيحة يقدمها لزملائه الأوكرانيين فهي “أن يتحلوا بالصبر في هذه الحرب الجديدة التي ستطول”، في مواجهة رئيس روسي قادر على ارتكاب أسوأ الانتهاكات لتوسيع إمبراطوريته، مضيفا “بالأمس كنت على اتصال بطبيب بالمستشفى الرئيسي في لفيف يتحدث عن نقص الأدوية وعن المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بشكل عاجل. وكما هي الحال في سوريا، سيضطر المتدربون إلى العمل كأطباء، وسيصبح الممارسون العامون جراحين، مع قلة النوم والإرهاق والصدمات. ولكن عليك أن لا تنهار. إذا غادر الأطباء، سينهار المجتمع بأكمله. بوتين كالأسد يعرف ذلك. وهذا هو سبب استهدافهم”.
الحرائق اشتعلت في كثير من المباني على أثر القصف (الوروبية)
حرب المعلومات
ويورد الكاتب أن الناشط السوري رائد صالح أيضا عينه على أوكرانيا، فهو يقدم -في مقطع فيديو على تويتر- تضامن منظمته “الخوذ البيضاء” الكامل مع السكان، ويصر في مقابلة مع موقع “مونيتور” على أنه “من المهم توثيق كل شيء في الوقت الفعلي”، ولذلك يقترح على فرق الإنقاذ الأوكرانية تركيب كاميرات صغيرة على خوذهم، للتحايل على آلة الدعاية الروسية التي لم تتوقف عن استهداف منظمته غير الحكومية.
وخلص الكاتب إلى أن الحرب الدائرة على الأرض الأوكرانية، كما هي الحال في سوريا، هي أيضا حرب معلومات، خاصة أن بوتين مثل الأسد يفعل كل ما في وسعه لتشويه المعلومات الموضوعية والموثوقة بمساعدة المتصيدين الذين يهاجمون النشطاء والأطباء والصحفيين، وبنشر الأخبار المزيفة التي يتم بثها على الشبكات الاجتماعية، مع دعم جرعة جيدة من الخطاب المعادي للغرب وأميركا، من أجل زرع البلبلة وترويع السكان.
المصدر : لوفيغارو
—————————-
جندي يتهيأ لتفجير آخر جسور العاصمة وميكانيكيون تحولوا لصناع سلاح.. قصص من استعدادات سكان كييف لحرب شوارع مع قوات روسيا
رغم الحزن الظاهر عليه، يبدي الجندي “كاسبر” من وحدات المتطوعين الأوكرانية استعداده لتفجير القنابل المحيطة بالجسر الأخير الذي لا يزال يربط بين كييف وضواحيها الغربية، في ظل زحف القوات الروسية على العاصمة.
وسبق أن فجّر رفاقه كل الجسور الأخرى على الجانب الغربي من العاصمة الأوكرانية، في محاولة يائسة لوقف تقدم الدبابات الروسية.
والجسر الوحيد الذي لا يزال قائما على نهر في بلدة بيلوغورودكا (25 كيلومترا غرب العاصمة) يؤدي إلى قرى خضراء تضم العديد من المساكن الصيفية، لكنها صارت الآن منطقة حرب.
وسيتم عزل مدينة كييف عن المناطق المحيطة بها من ناحية الغرب إذا تلقى “كاسبر” أمرا بتفجير الجسر.
ويقول الجندي المظلي السابق لوكالة الصحافة الفرنسية “سنبذل قصارى جهدنا لإبقائه قائما”، لكن القتال الذي يقترب يضرب معنويات الأوكرانيين الساهرين على المتاريس.
وانضمت طائرات حربية روسية إلى القوات البرية في قصف قرى وبلدات قريبة.
وتبدو طوابير اللاجئين الفارين من اقتراب القتال بلا نهاية، وساعات الهدوء القليلة الفاصلة بين الضربات جعلت الجنود الأوكرانيين يخشون من أن تكون القوات الروسية تستعد لهجمات أكثر عنفا.
يراقب “كاسبر” طائرة الاستطلاع المسيّرة الأوكرانية التي تحلق فوق خط المواجهة، ويدرك أنه قد يضطر قريبا إلى تدمير الجسر الأخير الذي لا يزال يربط بين كييف وضواحيها الغربية.
ويضيف “إذا تلقينا الأمر، أو إذا رأينا تقدم الروس، فسنقوم بتفجيره بأكبر عدد ممكن من دبابات العدو”.
الاستعداد لحرب الشوارع
مع بلوغ القتال ضواحي كييف، أصبحت الشوارع خطرة بشكل متزايد ومهجورة نهارا، في حين باتت القوات الروسية تبعد نحو 50 كيلومترا من وسط العاصمة بعد تقدمها على الضفاف الشرقية لنهر دنيبر.
لكن القطاع الغربي يتيح للقوات الروسية إمكان الوصول المباشر إلى وسط العاصمة وإلى الحيّ الذي يضم مقر الحكومة.
وفي ظل تلك المخاوف، يستعد السكان لحرب الشوارع، مثل الميكانيكي أولكسندر فيدشينكو (38 عاما) الذي استضاف سابقا في أوقات فراغه تصوير البرنامج التلفزيوني المخصص للسيارات الأكثر شعبية في أوكرانيا، لكنه حوّل مرآبه الواسع إلى مركز سريّ لتصنيع الأسلحة لتجهيز وحدات المتطوعين الأوكرانيين.
يقول فيدشينكو “عندما بدأت الحرب تغيّر كل شيء”، قبل أن يضيف “اكتشفنا أن ميكانيكيينا يعرفون كيفية صنع الأسلحة، ويعرف آخرون كيف يصنعون زجاجات مولوتوف. نحن نفعل كل ما في وسعنا”.
قد يكون يومنا الأخير
استبدل جميع العاملين في ورشة إصلاح السيارات التابعة لفيدشينكو معاطفهم الملطخة بالزيت بالزي الرسمي الأخضر الزيتوني لوحدات المتطوعين.
يقوم متطوع ميكانيكي آخر هو “كروس” (28 عاما) بصيانة مدفع رشاش من العيار الثقيل غنمه الجنود الأوكرانيون بعد استيلائهم على دبابة روسية.
يحاول “كروس” تحويل المدفع الرشاش إلى سلاح محمول يمكن لمتطوع غير مدرب استخدامه في معارك الشوارع، ويرى أن “هذا الشيء قد لا يصوب بدقة، لكنه أفضل من لا شيء”.
ويضيف “كم من الناس يعرفون أننا نفعل هذا، وربما لا يكون الأمر قانونيا، لكن مع الحرب ما هو قانوني لم يعد مهما، فقط دفاعنا الوطني يهمنا”.
ويشرح فيدشينكو “شعرت بالعجز، سأحمل بندقية كلاشنيكوف بين ذراعي، ولن أصمد 10 دقائق، لكنني بحاجة إلى القيام بشيء ما”.
وأصبح مصنع أسلحته المرتجل معرّض بشكل خطير لضربة روسية محتملة، حيث يقع مرآبه الواسع على طريق في الطرف الغربي من كييف، والعديد من المباني الصناعية على الطريق نفسها صارت أثرا بعد عين.
يتابع الميكانيكي “يعلم الجميع هنا أنه يمكن مهاجمتنا في أي وقت. الجميع يعرف أن هذا قد يكون يومنا الأخير، لكنهم يواصلون المجيء”.
تغالب الدموع أيضا المتقاعدة غانا جالينشينكو (64 عاما) وهي تسير بمفردها في الحقول بالمنطقة الفاصلة بين الجسر الذي يحرسه “كاسبر” والقرى التي سيطرت عليها القوات الروسية.
وتقول بصوت مرتجف “لا أعرف أين أبنائي، أتصل بهم بالهاتف لكن لا أحد يجيب”.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية
——————————
الهجوم الروسي على أوكرانيا.. ما سر تمسُّك طرفي الحرب بالمدنيين لهذه الدرجة؟
عربي بوست
قبل حتى أن يبدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، كانت قضية المدنيين تُستغل كأحد مبررات الصراع، والآن بعد اندلاع الحرب اكتسب المدنيون أهمية خاصة للطرفين، فما سر تمسك الروس والأوكرانيين بالمدنيين؟
ويعيش في أوكرانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 44 مليون نسمة، أقلية روسية تتركز بالأساس في الأقاليم الشرقية المتاخمة للحدود مع روسيا وبيلاروسيا، ومع اشتداد الأزمة الجيوسياسية بالأساس بين الغرب وروسيا وبينهما أوكرانيا التي تريد حكومتها الاندماج أكثر مع الغرب والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وربما حلف الناتو أيضاً، أصبحت الأقلية الروسية بأوكرانيا حجر الزاوية في تلك الأزمة.
إذ دعمت روسيا الحركات الانفصالية المسلحة في شرق أوكرانيا منذ أواخر عام 2013، وضمت إقليم شبه جزيرة القرم عام 2014. وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد 21 فبراير/شباط، مرسوماً اعترف من خلاله باستقلال لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس بالاستقلال، ثم شن الهجوم على أوكرانيا بعدها بأربعة أيام، وهكذا بدأت الحرب المستمرة منذ 12 يوماً.
الممرات الآمنة للمدنيين
بشكل عام تتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية مباشرة في تجنيب المدنيين التعرض للقتل أو الإصابة، وهذا ما تنص عليه المعاهدات الدولية، لكن حقيقة الأمر هي أن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً للحروب ربما أكثر من العسكريين أنفسهم.
ومنذ أن بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، تتصدر معاناة المدنيين الأوكرانيين التغطية الإعلامية من الجانبين، فروسيا تقول إنها شنت ما تسميها “عملية عسكرية خاصة”، بهدف معاقبة من تصفهم بالقوميين الأوكرانيين الذين يشنون إبادة جماعية ضد الأقلية الروسية، بينما تتهم كييف موسكو باستهداف المدنيين الأوكرانيين في أنحاء البلاد، خاصةً المدن الكبرى.
وفي ظل تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن المدنيين، غادر أوكرانيا حتى اليوم الثاني عشر من الحرب مئات الآلاف من المدنيين أصبحوا لاجئين في بولندا ودول أخرى بأوروبا، وتتوقع بعض المنظمات الدولية أن يتخطى عدد اللاجئين الأوكرانيين أكثر من 5 ملايين، دون تقديم تفاصيل أو مدى زمني.
في هذا السياق، بدأ الحديث يتكرر حول إنشاء ممرات آمنة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدن الأوكرانية الكبرى التي تحاصرها القوات الروسية من العاصمة كييف إلى ماريوبول في الشرق وأوديسا بالغرب وخاركيف في الشمال الشرقي وغيرها.
أوكرانيا
أوكرانيون في الملاجئ خشية القصف الروسي – Getty Images
وعلى الرغم من أن المفاوضات المباشرة بين الروس والأوكرانيين بدأت منذ الإثنين 28 فبراير/شباط وأجريت أكثر من جولة من تلك المفاوضات وكان إنشاء ممرات آمنة لخروج المدنيين البند الرئيسي على أجندة تلك المفاوضات، فإن تلك الممرات الآمنة لا تزال لم تعمل بالفعل حتى الإثنين 7 مارس/آذار.
وتدخّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكل مباشر، في قضية وجود ممرات آمنة لخروج المدنيين من المدن المحاصرة، وخلال اتصالاته مع نظيره الروسي بوتين أكد ماكرون تلك القضية، بحسب البيانات الصادرة عن الإليزيه، والأمر نفسه تكرر خلال اتصالاته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتم الإعلان أكثر من مرة عن اتفاق الروس والأوكرانيين على ممرات آمنة لخروج المدنيين، لكن في كل مرة تفشل الجهود ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن أسباب الفشل. والأحد 6 مارس/آذار، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن فشل محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
لماذا يتمسك الروس بالمدنيين لهذه الدرجة؟
في كل مرة يفشل الاتفاق على الممرات الآمنة لخروج المدنيين يتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بشأن مسؤولية ذلك الفشل. وفي ماريوبول، أعلن المجلس البلدي للمدينة أن القصف الروسي جعل عملية الإجلاء الآمن للمدنيين أمراً مستحيلاً، بحسب الرواية الأوكرانية.
بينما يصر الجانب الروسي على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الأوكرانية ويتهمها باستغلال المدنيين كدروع بشرية لتعطيل تقدُّم القوات الروسية، في ظل ما تقول موسكو إنه سعي من جانبها لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين.
والإثنين 7 مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، لتأمين ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن كييف وماريوبول وخاركوف وسوم-جومشافت، استجابة لطلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب، وأضافت أنه ستتم مراقبة العملية من خلال طائرات بدون طيار، حيث لن يكون أمام الجانب الأوكراني أي حجج لاتهام الجانب الروسي بالإخلال بالاتفاقية، بحسب وكالة سبوتنيك.
كما أكدت الوزارة الروسية أنه سيتم إرسال جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.
كما تحدث بوتين هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وقالت الخدمة الصحفية بالكرملين: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الموقف الروسي فيما يتعلق بالعملية الخاصة لحماية جمهورية دونباس”.
“تمت مناقشة الجوانب الإنسانية للوضع الحالي في البلاد بالتفصيل. أوجز الرئيس الروسي موقف موسكو فيما يتعلق بإجراء العملية الخاصة لحماية جمهوريتي دونباس، وشدد بوتين على أن الجيش الروسي يتخذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين”. ووفقاً للكرملين، قال بوتين أيضاً إن التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتي من القوميين الذين يستخدمون التكتيكات الإرهابية، ويختبئون وراء السكان.
لكن تلك الممرات الآمنة لم يتم تنفيذها وفشل الاتفاق على وقف إطلاق النار، بعد أن اتهمت كييف موسكو بإجبارها المدنيين الأوكرانيين على المغادرة إلى روسيا أو بيلاروسيا فقط.
واتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، روسيا بمحاولة تضليل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء.
ودعت فيريشوك روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار اعتباراً من صباح اليوم؛ للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، وأضافت في إفادة أذاعها التلفزيون، أن أوكرانيا تلقت الاقتراح الروسي في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي بوتين، بحسب رويترز.
“أتمنى أن يدرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اسمه ومساعيه المخلصة للمساعدة… تُستغل في الواقع للتضليل من قبل الاتحاد الروسي”.
واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف مناطق مخصصة للممرات الإنسانية؛ وذلك لمنع السكان من الفرار من مدن تتعرض للهجوم، بينما قالت موسكو إن “ممرات” جديدة ستُفتح من كييف ومدينتي خاركيف وسومي الشرقيتين إضافة إلى مدينة ماريوبول الساحلية. وألقت موسكو بالمسؤولية على أوكرانيا في الإخفاق حتى الآن في تأمين ممرات إنسانية، ونفت استهداف مدنيين.
لماذا ترفض أوكرانيا رحيل المدنيين ناحية روسيا؟
وجهة النظر الروسية تتلخص في نقطتين رئيسيتين هما: أن استضافة المدنيين الأوكرانيين على أراضيها أو أراضي حليفتها بيلاروسيا يخدم روايتها الخاصة بأن هدفها من الهجوم ليس غزو أوكرانيا وإنما حماية المدنيين من الحكومة الأوكرانية، والنقطة الثانية تتعلق بتوظيف ورقة المدنيين في أي مفاوضات بشأن مستقبل البلاد بشكل عام.
أما الحكومة الأوكرانية فهي لا تريد أن يتوجه أي من مواطنيها إلى موسكو أو مينسك، وتفضل إما بقاءهم للمشاركة في الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم الروسي وإما الخروج ناحية الغرب كلاجئين بالدول الأوروبية، إذ سيخدم وجود عدد كبير من اللاجئين القضية الأوكرانية على المدى الطويل، إذا ما سيطرت روسيا على البلاد وتم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى.
وقبل حتى أن يبدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت الحكومة عن تسليح المدنيين وتدريبهم استعداداً للدفاع عن البلاد، ومع الأيام الأولى للهجوم، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية إرشادات لمواطنيها عن كيفية إعداد قنابل المولوتوف ومقاومة القوات الروسية في شوارع المدن الأوكرانية؛ لمنعها من التقدم.
وأعلن الرئيس زيلينسكي التعبئة العامة في البلاد داعياً جميع الأوكرانيين إلى حمل السلاح، وشمل القرار جميع المواطنين من سن 18 حتى 60 عاماً، وبالتالي فإن السماح بمغادرة المدنيين يكاد يكون محصوراً على كبار السن والأطفال وربما بعض النساء الحاضنات لأطفال صغار أو رُضع.
وأفادت تقارير إعلامية روسية، بأن عمدة مدينة سومي الأوكرانية، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، هدد السكان الذين يحاولون عبور الممرات الإنسانية “بإطلاق النار عليهم”.
أوكرانيا
وأعلن ذلك للصحفيين رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، حيث قال: “في ماريوبول، تم قمع شديد لأي محاولات من قبل السكان المدنيين والمواطنين الأجانب للتقدم في اتجاه أماكن التجمع للقوافل الإنسانية، ومن ضمن ذلك القتل”.
“إضافة إلى ذلك، أعلن عمدة مدينة سومي، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، مع قائد الكتيبة الوطنية، الساعة 11:50، وأقتبس، لن تكون هناك ممرات خضراء، ولن يذهب أي مدني إلى روسيا، وأولئك الذين يحاولون القيام بذلك سيتم إطلاق النار عليهم”، بحسب تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية.
وفي ظل صعوبة التحقق مما يقوله الروس أو الأوكرانيون بشأن الفشل في الاتفاق على ممرات آمنة ووقف مؤقت لإطلاق النار بغرض مغادرة المدنيين من المدن المحاصرة، فالواضح أن الجانبين يتمسكان بورقة “المدنيين” ولكلٍّ أسبابه ومبرراته، فهل يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أعداد ضحايا الحرب من المدنيين؟ يرى فريق من المحللين أن إجابة هذا السؤال بالإيجاب قد تكون ضمن ذرائع الحكومة الأوكرانية لرفض مغادرة المدنيين، فالجانب الروسي هو من سيتحمل تبعات هذا السيناريو الكارثي بطبيعة الحال.
———————–

======================
تحديث 09 أذار 2022
——————–
الممانعة إذ تنصر بوتين ثقافياً/ إيلي عبدو
إعلام الممانعة يأبى عندنا إلا أن يشارك في حفلة السلطوية، فينصب “أخاً أكبر” ثقافي، لتخوين كل معترض على قتل الناس في أحياء كييف، تحت طائلة “الخضوع للرجل الأبيض”.
خصصت صحيفة “الأخبار” الناطقة باسم الممانعة، ملفاً ثقافياً، لتبرير حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، فتوزعت عناوين ملفها بين ثلاثة، “بلطجَة الغرب”، و”رُوسُوفوبيَا: في ذمِّ مثقف الكولوناليات الشَّقراء” و”في متاهة النيوكولونيالية: عرب وضاعوا”، فضلاً عن عناوين المقالات التي تركزت على مركزية سردية الأوروبي وعدم تصديق الروايات المضادة لتلك التي يصنعها “الرجل الأبيض”. وهذه العناوين إذ، تستعيد لازمة ثقافية شعبوية مكررة حول كراهية الغرب وأبلسته وجعله سبب كل شرور العالم ومشكلاته، فإنها تضع مثقفين عرباً، قدموا مقاربات متفاوتة حول الغزو الروسي، في قفص الاتهام، باعتبارهم غير مؤيدين لمغامرات “القيصر” وحروبه. ويتم تغليف الاتهام، بعناصر اللازمة الثقافية، بحيث يبدو التقاعس عن تأييد النظام الروسي، سقوطاً في “النيوكولونيالية” و”خيانة”، وخضوعاً لـ”المركزية الأوروبية”.
في تصميم النسخة الورقية للملف، وُضعت صورة عملاقة، للكاتب الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، وأمامها مقتطفات من كلام المثقفين المستهدفين وسواهم. فبدى سعيّد الذي خصص جزءا كبيراً من كتاباته لتحذيرنا من خطر اختراع الغرب صورتنا لنا واستغلالها في السياسة، “أخ أكبر” يراقب كتابات، لا تروق له، ولا تتطابق مع حساسيته المناهضة لتمثلات الغرب لنا. ويحضر سعيد أيضاً في الشهادات المنتقاة، إذ يُخصص له مقتطف من مقالة بعنوان، “خيانة المثقّف، لا مقاومة من دون ذاكرة”، نُشِرَتْ في “لوموند ديبلوماتيك” آب/ أغسطس 1999، “في سياق القصف الأطلسي الممنهَج لصربيا”، بحسب الصحيفة. وينتقد سعيد في كلامه المجتزأ، التضحية بالديبلوماسية على اعتبار أن الضحية ليست من الجنس الأبيض، ويرفض “تمويهُ الوطنية في شكل نزعة قومية”، بحيث يصير الإخلاصُ للأمة “أقوى من الوعي النقدي”، و”خيانةَ المثقفين وإفلاسهم الأخلاقي يصيران في حكم القضاء المبرَم”.
وبمعزل عن السياق الذي حكم آنذاك نص سعيد، وتقييمنا له، فإن هدف الممانعة، في استحضار جزء من النص، هو التلميح تجاه “المقاومة الأوكرانية” ضد جيش بوتين، حيث يتقاطع كلام سعيد المختار مع اتهامات الرئيس الروسي لمن يتصدى له في أوكرانيا بـ”القوميين المتشددين”.
وبقدر ما تبدو الاستعانة بسعيد، انتقائية، إذ يتم الاعتماد على مقتطف من مقال، لبث رسالة ضمنية تؤبلس “المقاومة الأوكرانية” بقدر ما يبدو صاحب “الاستشراق”، المرجع المثالي الذي تعود إليه الممانعة عند كل حدث ليمدها بالحجج والمبررات الثقافية، بهدف خلق اصطفاف سياسي، مع ديكتاتور أو نظام قاتل. فسعيد، وفر بنية تحتية فكرية، للتشكيك والاشتباه بكل ما يأتي من الخارج، ما حرم الداخل، المستعصي على إحداث تغيرات جوهرية، أيَّ إمكانية للارتباط بالعالم، في سياق تفاعلي منتج، غير استهلاكي يكتفي بالتقنية. لذا، تمت “عملقة” الكاتب الراحل، في تصميم الملف، ليحاسب المثقفين الرافضين للغزو، وهؤلاء بحسب مقدمة الملف، تابعون لـ”أنظمة بدورها تابعة للقوى الاستعمارية مباشرة”. ويقدمون خدمات “للسفارات والقنصليات وصنائعها من جماعات السلفية الجهادية” ولا يجدون ضيراً “في تبرير حصار العراقيّين وتجويعهم (العقوبات الغربية على نظام صدام حسين)، ولا في تقديم خدمات استشاريّة للبنتاغون”. النزعة الاتهامية، بمعزل عن ابتذالها، تنطلق من فكرة الابتعاد من التأثير السعيدي في الثقافة العربية، خصوصاً التعامل مع الغرب. وتحصر التعامل مع الأخير إما برفضه باعتباره “رجلاً ابيضاً”، و”هيمنة” و”مركزية”، و”استشراق” أو التخوين والخضوع والتسليم بمرجعية الآخر. لا مكان للعقلانية في مقاربة الممانعة لهذه المسألة، لا سيما أن معيارها هو إدوار سعيد، إذ إن اعتماد الأخير، كمرجع ومثال، لبناء خلطة ثقافية تنحدر نحو الشعبوية والاتهامات، هدفه سياسي، بحيث يبدو سعيد والمفاهيم الناقدة للكولونيالية، في خدمة بوتين ولتلميع صورته.
ومع أن القيمين على الملف، عمدوا إلى التذاكي، فنوّعوا في اختيار المثقفين، وأدرجوا آراء متفاوتة حول غزو أوكرانيا، شملت سلافوي جيجيك ونعوم تشوميسكي عالمياً، وشعراء وباحثين عرباً، بينهم زكريا محمد. لكن المستهدفين، كانوا بوضوح، الشاعر اللبناني عباس بيضون الذي اعتبر “عبادة القوة في العقل القومي” وراء الافتنان العربي ببوتين وغزوه، والناقدة العراقية فاطمة المحسن، التي انتقدت قفزة بوتين الحمقاء مقارنة إياها بغزو صدام حسين الكويت، والشاعر المغربي، عبد اللطيف اللعبي الذي دعا إلى الوقف مع الشعب الأوكراني الذي يقف في الخطوط الأولى “للدفاع ضد الهمجية”.
هكذا، أدمجت، بخبث وتلاعب، آراء، بيضون والمحسن واللعبي النقدية تجاه الغزو، ضمن مقدمة نارية ضد المثقفين “التابعين”، وصورة عملاقة لـ”الأخ الأكبر” إدوارد سعيد، وعناوين اتهامية حول “الخضوع” لسرديات الغرب، كي تبدو أمثلة لموضوع الملف وأهدافه التي لم تقتصر على التخوين غير المباشر لرافضي الغزو، وإنما امتدت لتناصر البروباغندا الروسية حول اجتياح أوكرانيا. وللقيام بذلك، لا بد من العودة من جديد لسعيد، باستحضار مقولة من كتابه “الثقافة والإمبرياليّة”، حول “الخضوع للمستعمر”، كمدخل لمقال مستقل حول أسباب قبولنا الرواية الغربية للغزو وعدم تصديقنا الرواية الروسية “المضادة”. إذ يسهب كاتب المقال، بالحديث عن “التبادل اللامتكافئ للثقافة والأفكار بين حضارتَين”، وعن التفوق الأميركي عبر اللغة والتعليم وهوليود، ليخلص أن هناك “طاّبور خامس” يحبس “نفسه في كهف أفلاطوني يرى فيه الديموقراطية التمثيلية والفردانية والقوّة والسلع الأميركية منتهى الحضارة الإنسانية، من دون أن يتخيّل عالماً آخر خارج هذا الكهف لا نكون فيه أتباعاً لأحد”. والكاتب، لا يحتاج لمواصلة مقاله، لنعرف أن العالم الآخر، ليس سوى روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية وإيران، أي كل القوى المناهضة للغرب. علما أن هذه الأخيرة أو بعضها، لا تتفق مع المعيارية السعيدية المهجنة التي تضعها الممانعة، ذاك أن النظام الروسي قريب جداً من أقطاب يمينيين في أوروبا، يمجدون “الرجل الأبيض ومركزية الغرب”، والنواة الصلبة التي تلتف حول بوتين مجموعة “أولغارشيين”، من المفترض أن تمتلك الصحيفة صاحب الملف، حساسية “يسارية” تجاههم.
هذه التناقضات، لا تمنع الممانعة من العودة في دفاعها الثقافي على بوتين، إلى بضاعتها الكاسدة، حول “هيمنة الغرب” وخضوعنا له، وفبركة مفاهيم غير علمية، وعناوين طنانة، لتفتح محكمة تفتيش ضد مثقفين رافضين للغزو البوتيني، وتنصب إدوارد سعيد “أخا أكبرا” كمعادل لـ”الأخ الأكبر” في روسيا، أي فلاديمير بوتين، فقبل ساعات على نشر الصحيفة الممانعة ملفها، أقر “القيصر” قانوناً يعاقب بالسجن كل من ينشر “أخبارا كاذبة”، فضلا عن حظر “الفيسبوك” و”التوتير”، والتضييق على الإعلام المستقل لدفعه لمغادرة البلد.
هكذا، يتاح لـ”الأخ الأكبر”، مراقبة أي اعتراض على غزواته في روسيا، وإعلام الممانعة يأبى عندنا إلا أن يشارك في حفلة السلطوية تلك، فينصب “أخاً أكبر” ثقافي، لتخوين كل معترض على قتل الناس في أحياء كييف، تحت طائلة “الخضوع للرجل الأبيض”.
درج
———————————
«رُوسُوفوبيَا»: في ذمِّ مثقف الكولونيالــيّات «الشَّقراء»
ترجمة تحرير وتقديم: رشيد وحتي
بسحب أبي رغال، الدليلِ العربي لجيش أبرهة، من سياقه التاريخي، صارَ استعارة يمكن أن تنطبق على بني جلدتنا من المثقّفين الذين استرشدت بهم الحملات الاستعمارية القديمة والنيوكولونيالية الرّاهنة لسحق الشعوب وتضليلها… وفي أدنى الدرجات ادّعاء التزام حياد بارد بزعم خلال احتدام الصراعات المحلية والإقليمية والدولية. وربما كان أمثل نموذج على ذلك توصيف بورخيس لحرب جزر المالوين بين بلاده الأرجنتين وإنكلترا بأنّها «أصلعان يتحاربان من أجل مُشط».
أما بلادنا العربية، فقد عرفت دوماً المثقَّف التَّابع، سواء لأنظمة بدورها تابعة أو للقوى الاستعمارية مباشرة. لكن الأنكى هو ما برز قبل وخلال وبعد سقوط بغداد (2003) وخلال الطوفان السوري، ظاهرةُ ما يمكن تسميته بـ «المثقّف اليساري السابق الذي يقدّم خدماته للسفارات والقنصليات وصنائعها من جماعات السّلفية الجهادية». ولئن شهِدنا حتى أواخر القرن الماضي تحالفات لا تفاجئ أحداً، تمتد من اليمين الليبرالي المحلي حتى أسياده الغربيّين مروراً بجماعات الإسلام السياسي؛ فقد أُضيف لهذا التحالف ــــ مع بداية القرن الحالي وقَبْلَهُ مع التّيه الأيديولوجي المتأتّي من تفكّك الاتحاد السوفياتي ــــ المثقفُ «اليساري» السابق، الذي لا يرى ضيراً في تبرير حصار وتجويع العراقيّين، ولا في تقديم خدمات استشاريّة للبنتاغون وما يوازيه من أذرع عسكرية ومخابراتية، ولا حتى في تدبيج «رسالة شكر وعرفان واعتراف بالجميل إلى الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير وإلى الشعبين الأميركي والبريطاني وجيشَي البلدين في مناسبة تسليم السلطة للعراقيّين» (كان وراء الرسالة المفكّر التونسي المجالِسي العفيف الأخضر، صاحب أدقّ وأكمل ترجمة لـ «البيان الشيوعي» والسريالي العراقي المتمركس عبد القادر الجنابي). سياق هذه المقدمة هو الهستيريا الغربية الحالية التي تريد بالقسر والتضليل صنع رأي عالمي مصاب بما يشبه الـ «روسوفوبيا» الذي نَدُرَ أن يتميز به المثقّف العربي (والعالمثالثي عموماً) عن المثقّف الغربي. بل إنّ بعض مواقف الأول تكاد تكون استنساخاً مبتذلاً لمواقف الثاني (كما هو واضح في بعض نصوص الملف أدناه). وبالعودة إلى الروسوفوبيا، فنحن ندرك جيداً أنّ المنظومة الروسية الحالية لا يمكن أبداً اعتبارها لا تقدّمية ولا ذات أدنى صلة باليسار العالمي، لكننا كنا دوماً نُنَزِّه وِيتْمَنْ وهمينغواي عمّا يقترفه البنتاغون، ولا نأخذ كاتباً أو فناناً بجريرة رئيس. لكنّ توالي ما جرى بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا من ردود أفعال غربية طالت التراث الأدبي والفني الروسي وإعلامه بلغ حدّاً من السخافة والقرف لا يسعنا إزاءه إلا التضامن المطلق مع ضحاياه: فمن وقف تدريس دوستويفسكي في «جامعة بيكوكا» الإيطالية (تم التراجع عن القرار بعد حملات الضغط والاستهجان)، إلى فرض «الجمعية الدولية للقطط» عقوبات على القطط الروسية، إلى وقف «نتفليكس» تصوير فيلم مقتبَس عن «آنا كارنينا» للروائي العظيم تولستوي، مروراً بمنع الرياضيّين والسينمائيّين والموسيقيّين والراقصين الروس من المشاركة في أيّ مهرجانات أو لقاءات أوروبية ودولية… كلّ هذا ولا يكفّ الغرب عن تذكيرنا بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فنّان، قادم من العالم الفني. في خضم هذا الصراع المحتدم، حيث تحاول أكثر من قوة قتل الروح النقدية وعزل الأحداث عن سياقاتها التاريخية، قمنا في هذا الملف بتجميع آراء راهنة (مرتبطة بالحدث) وأخرى فكرية/ نظرية (تستند إلى قراءة تاريخية لمآلات التطور البشري)، ولم نشأ التعليق على بعضها فرادى، رغم ما تحويه من تضليل، تاركين للقارئ تكوين رأيه الخاص به، بتحفيزه على معرفة وتحرٍّ يحاولان العودة إلى جذور القلاقل التي يتتبعها الآن على الشاشات
عبد اللطيف اللعبي (*)
المجدُ للشعب الأوكراني
يدرك الكُلُّ بأيّ قدر من الشجاعة، من الإصرار، قاد الشعبُ الأوكراني، في 2014، ثورتَه من ساحة مايْدَنْ، مجبِراً رئيسَ ساعتئذٍ، خادِمَ سيد الكرملين، على جمع حقائبه، ما سمح أخيراً بإجراء انتخابات حرَّة في البلاد والخلاص إلى إقامة ديموقراطية حقيقية.
الحربُ دون هوادة التي يقودها النظام الديكتاتوري ضدَّ الديموقراطية الأوكرانية الفتيَّة لا يمكن وصفُها إلا بالجريمة ضدَّ الإنسانية.
فلا ينبغي لنا أن نأخذ التهديد الذي يلوِّح به فلاديمير بوتين على محمل استهتار. فهو نابعٌ من شخص يمكن حقاً التشكيك بتوازنه العقلي. هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يمكن فيها لما لا يخطُر على بال (أعني الاستعمال غير اللائق وخارج أيّ ضبط للسلاح النووي) أن يحدث، للأسف، لينتج عنه أمر آخر لا يخطُر على بال: كارثة على صعيد الكوكب، ستضع استمرار الجنس البشري موضِعَ خطر.
في الوضع الراهن، أفضِّل أن أكون «متخوِّفاً» على أن أكون «واقعياً». فاليوم، لا يفعل بوتين إلّا ما اقترَفَه هتلر في 1939 باجتياحه بولونيا كمقدمة لمشروعه الإجرامي في التوسع والإبادة. مع هذا الفرق، المروّع رغم ذلك، المتمثل في كون بوتين يمتلك ترسانة نووية لا سبيلَ لها أن تضاهي نظيرتها لدى باقي القُوى.
لهذا أظُنُّ أنّ الخطبَ جَلَلٌ، جِدُّ جللٍ. الدعم المتعدِّد الأشكال، ودون أدنى تحفّظ، للشعب الأوكراني المِقدام، ينبغي له أن يصير واجباً إنسانياً، كونياً، فهذا الشعب هو المتواجِد، اليومَ، في الخطوط الأولى للكفاح ضد الهمجية، مقدِّماً من أجل ذلك أكبر التضحيات.
– عن صفحة الشاعر الخاصة على فايسبوك.
(*) شاعر مغربي (فاس، 1942)، مقيم حالياً في فرنساً. مؤسّس مجلة «أنفاس» التي كانت رائدةً في التعريف بالثقافة التحرّرية وفضح الخطاب الكولونيالي. معتقَل سابق، باعتباره من أبرز قادة حركة «إلى الأمام» الماركسية-اللينينية. أهم فصائل اليسار الجديد المغربي في سبعينيات القرن الماضي.
محمد الناجي (*)
اتِّخاذُ موقف؟
بكلّ بداهة لا، ليست المسألة أبداً في أخذ موقف، فالأطرافُ المتحاربة لا تكترث أبداً بتموقُفِنا المفترَض. ففي حكم المؤكَّد أننا ضدّ الحروب، إذ نحن أكثرُ ضحاياها. ولكن، رغماً عنَّا، تضعنا هذه الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتلكَ المقَنَّعة للحلف الأطلسي ضد روسيا، أمام موقف، بمعنى أنّها تُرينا مكانَنا الحقيقي، وتعكس لنا وجهَنا الحقيقي، نحن لا شيء، ففي العالَم العربي ــ الإسلامي وخَارِجَه، هوجمت الشعوب، قُنْبِلَتْ، أُفْقِرَتْ، هُجِّرَت، والأدهى من كل هذا: تَمَّ تجريمها في وسائل الإعلام الصهيوغربية، علينا أن نجهَر بهذه العبارة من دون خوف، لأنها تصف الواقع كما هو. هذه ليست حربنا، ولكنها في الوقت نفسه تعنينا مباشرة، وهي تُشير لنا بالإصبع من دون أن تلقي في اتِّجاهِنا ولو أبسطَ نظرة، لِتُفْهِمَنَا قيمتنا كأصفار في عيون الغرب.
يموت الأطفال في فلسطين في كلّ وقت، وفي هذه الأيام بالذات، لكنهم مجرد أطفال عرب، إرهابيون افتراضيون في «الأرض الإبراهيمية المقدَّسة جداً»، رغم أنّها عربية، كما يريدُ ذلكَ التفكير الديموقراطي جداً والحرّ لدى الفرنسيّين وغيرهم. لكن، لِنَعِ على الأقل أنّ الغرب وحش يسلِّط عليه هذا الصراعُ الأضواءَ، والاقتناع بذلك يمثّل على الأقل تقدُّماً. ابتلع الصحافيون والمعلِّقون ألسنتهم وصاروا يردّدون، من دون أن يرفَّ لهم جفنٌ، نفسَ الخطاب. لكن يتوجّب علينا تحية بعض الأصوات، النادرة جداً في الواقع، التي تجرُؤُ على تذكيرنا بسياق هذه الحرب، ولِمَ تمَّ إشعالها، ومن هم محرِّكوها الأساسيون. وعلينا أن نتذكَّر أيضاً أنهم إذا كانوا بحاجةٍ، مرة أخرى، إلى أراضينا ومواردنا، لن يتردّدوا أبداً في سلبنا إيَّاها، مع إمطارنا بالقنابل باسم الكفاح من أجل الديموقراطية في وجه الهمج. العار لبلدان الأنوار حيث تَعُمُّ منذ الآن الظَّلاميَّة!
– عن فايسبوك.
(*) عالِم اجتماع مغربي وأستاذ في «جامعة محمد الخامس» في الرباط
زكريا محمد (*)
غربٌ فاشي
الغرب الذي أراد أن يظهر دوماً هادئاً ورزيناً تحوّل أمام أول اختبار لما يُعتقد أنه تهديد لأمنه إلى غرب فاشي شعوباً وحكومات.
■ ■ ■
الغرب يسلك سلوك عصابات بلطجيّة. يمنع وصول الحقيقة إلى الناس بكلّ طريقة. فهناك حقيقة واحدة فقط هي التي تقرّرها العصابة الغربية.
■ ■ ■
للمرة الأولى منذ عقود طويلة جداً، تتشكل فرصة للمبادرة إلى الاشتباك مع إسرائيل من جانبنا. فأميركا والغرب مشغولان بحربهما الضارية التي ستطول مع روسيا. وهذا ما يجعلهما بيدين مكبّلتين تجاه أحداث منطقتنا، فهما لا يستطيعان الدخول في حربين معاً. لذا فأسوأ كوابيسهما هو أن تحصل حرب ضد إسرائيل.
بناءً عليه، فهذه فرصة لم تحصل من قبل للقوى التي تسمّي نفسها مقاومة وممانعة ومدافعة وما إلى ذلك من أسماء. هذا هو وقتها إن أرادت الفعل حقاً. ولن تحصل على فرصة أفضل من هذه أبداً. هذه هبة من الله، وفرصة لا تفوّت مطلقاً.
إنها فرصة لتحقيق الكابوس الغربي.
غير ذلك سيكون هراء.
أما الهراء الأكبر، وهو هراء مثقّفين وإخونجيّين، فهو أن نذهب إلى الحرب إلى جانب الأوكرانيّين بدل ذلك.
– عن فايسبوك
(*) شاعر وباحث فلسطيني
سلافوي جيجيك (*)
الحرب العالمية الثالثة
ثمّة إذن، على ما يبدو، صنفان من اللاجئين، لاجئونا (الأوروبيون)، أي «اللاجئون الحقيقيون»، ولاجئو العالم الثالث، الذين لا يستحقّون ضيافتنا. نشرت الحكومة السلوفينيّة تغريدة على حسابها على تويتر، يوم 25 شباط (فبراير)، مقيمةً بكل وضوح هذه التفرقة: «لاجئو أوكرانيا قادمون من بيئة ثقافية، دينية وتاريخية مختلفة كلياً عن نظيرتها لدى اللاجئين الأفغان». بعد الضجة التي افتعلتها هذه التغريدة، سحبها مقترفوها سريعاً، لكن مارد الحقيقة الوقحة انفلت من القمقم للحظة وجيزة.
بعد العدوان الروسي، فضَّل بعض المتموقعين «يساراً» (لا يمكنني استعمال الكلمة، في هذا السياق، من دون زوجي مزدوجات) توجيه اللوم إلى الغرب. القصة معروفة: الأطلسي يخنق ويزعزع روسيا ببطء؛ ولنتذكر أنّ الغرب هاجم روسيا مرتين خلال القرن الماضي. ثمة فعلاً بعضُ حقيقةٍ هنا، لكن التصريح به يبرّر لهتلر إلقاء اللوم على اتفاقية فرساي التي حطّمت الاقتصاد الألماني. ما يعني أيضاً أنه قد يكون للقوى الكبرى حقّ مراقبة مجالات تأثيرها، مضحيةً باستقلالية الأمم الصغيرة على مذبح الاستقرار العالمي.
ما يفعله بوتين الآن استنساخ متأخّر للتوسّعية الإمبريالية الغربية. ولصدّه، علينا مدّ جسور نحو بلدان العالم الثالث، التي للعديد منها قائمة طويلة من الإدانات المبرَّرة ضد الاستعمار والاستغلال الغربيَّيْن. لا يكفي «الدفاع عن أوروبا»: تتمثّل مهمّتنا الحقيقية في إقناع دول العالم الثالث أننا، في وجه مشكلاتنا العالمية، نستطيع أن نقدم لهم خيارات أحسن من خيارات روسيا أو الصين، وأنّ الطريقة الوحيدة لبلوغ ذلك هي أن نغيّر أنفسنا فيما وراء السياسة الملائِمة المابعد كولونيالية، أن نتخلّص من دون رحمة ممّا فينا من أشكال النيوكولونيالية، بما فيها تلك المقَنَّعة بالمعونات الإنسانية. وإذا لم نقم بهذا، فما علينا إلّا أن نتساءل لماذا لا يرى أهالي العالم الثالث في الدفاع عن أوروبا دفاعاً أيضاً عن حريّتهم، لا يرون ذلك لأننا لا نقوم به حقاً. هل نحن مستعدون للقيام به؟ أشك في ذلك.
ـــ عن «نوفيل أوبسرفاتور»
(*) فيلسوف سلوفيني، يَحتسب نفسه من أهمّ مؤثّري تيار اليسار الراديكالي، يغرف من هيغل، ماركس ولاكان
فاطمة المحسن (*)
القفزة الحمقاء
القفزة الحمقاء في الهواء تكلّف الشعوب أثماناً باهظة. لعل غزو بوتين لأوكرانيا يذكّر بما فعله صدام في الكويت. فصدام لم يكن يؤمن بالتاريخ ولا تحرّك الجغرافيا، ولهذا وقع في حفرتيهما بسهولة. كان يردّد مثل بوتين اليوم، هذا الجزء المقطوع من الشجرة الأم وأريد إعادة الفرع إلى الأصل. طبعاً، هذه كذبة فصيحة لابتلاع ثروات الكويت بعدما أفلس. وهكذا غدت الحفرة جاهزة. لكن ما هو الثمن الذي ستدفعه روسيا في ظلّ وضع عالمي جديد؟ لعلّها لن تخضع لعقوبات في المستقبل مثلما جرى للعراق، ولن تضطر لدفع تعويضات لجارتها العزيزة أو لشقيقتها المنتقمة، فالعراق دائماً يسقط في شرك مصالح الأخوة الأعداء.
حمى الله الشعوب من حروب النقمة والانتقام، وقرارت الغطرسة والوطنيات الحمقاء.
– عن فايسبوك
(*) كاتبة وناقدة عراقية
كفى الزعبي (*)
أزمة فكرية
انتقلت الأحزاب الشيوعية العربية إلى الرفيق الأعلى ما إن انهار الاتحاد السوفياتي. أمّا فتات هذه الأحزاب من شيوعيّين عرب، فقد ورثوا أسوأ ما في هذه التجربة: أزمتها الفكرية التي أخذت تتجلّى بوضوح منذ بداية هذا القرن إبّان احتلال العراق وظهور «شيوعيّين أميركيّي الهوى». ثم تجلّت هذه الأزمة أكثر مع بداية «الربيع» العربي بظهور شيوعيّين مؤيّدين لهذا «الربيع» على اعتبار أنه ثورة! وها هو بوتين الآن يستفزّ مشاعرهم التي تبدو لي في جوهرها ذات طابع قبلي (ولاء قبلي لرموز الحركة الشيوعية العالمية)، حينما انتقد لينين!
لقد أعلن بوتين مراراً وتكراراً أنّه ليس شيوعياً. إنه قومي روسي يدافع عن مصالح وطنه القومية الإستراتيجية التي تتناقض مع مصالح الغرب. الغرب لا يريد روسيا دولة قوية، وإن كانت تنتهج النمط الرأسمالي في الإنتاج، خصوصاً أنّ البنية الثقافية لهذه الدولة تتناقض جوهرياً مع البنية الثقافية الغربية. لقد سعوا لتدمير روسيا حتى في عهد يلتسين الذي سلّمهم كل شيء.
لكن الشيوعيّين العرب (سواء كانوا أميركيّي أو لينينيّي الهوى) يغضّون الآن النظر عن أنّ سياسات بوتين الخارجية تتقاطع مع المصالح القومية الإستراتيجية للعرب: لنا!
أنا شخصياً لا يهمّني الآن عمّال العالم ومن ضمنهم عامل إسرائيلي يحتلّ أرض فلسطين ويُصارع الرأسمالية (ولا سيّما أنّه في واقع الحال لا يصارعها، بل يصارع العامل الفلسطيني).
(*) كاتبة أردنية
عباس بيضون (*)
عبادة القوّة
عبادة القوّة عميقة في العقل القومي ونسيبه الديني العربيّين. هذا وراء الافتتان ببوتين والغزو الروسي لدى البعض غير القليل. لو وقف بوتين في شرق أوكرانيا لكانت له، بحسبه وحسبه وحده حجة. لكنّ التقدم إلى كلّ أوكرانيا، وإلى العاصمة يُظهر أنّ الهدف هو القضاء على أوكرانيا كلّها شعباً ودولة. أوكرانيا بالنسبة لبوتين، بلا شعب ولا وجود مثلها في ذلك مثل فلسطين بالنسبة إلى الإسرائيليّين…
– عن فايسبوك
(*) شاعر لبناني
غسان بن خليفة (*)
متنفّس لبلدان الجنوب
ملاحظات سريعة حول الحرب في أوكرانيا
– الاستخفاف بمشاهد الحرب وما تخلّفه من موت ودمار يدلّ على تبلّد في المشاعر وعلى تفاهة فكرية وأخلاقيّة.
– التعامل بمنطق «ضدّ روسيا وضدّ أوكرانيا» على حد سواء من دون محاولة تعليل هذا الموقف (على طريقة «كلنّ يعني كلّن» في لبنان) يدلّ على نوع من الكسل الذهني لدى البعض، وعلى نزعة أخلاقوية لدى البعض الآخر.
– الدفاع عن الطبقات الشعبية (أي الانتماء إلى الفكر الاشتراكي) لا يعني بالضرورة السقوط في خطاب ماركسي «أممي» سطحي من نوع «بوتين يكره لينين». لذا نحن ضدّه أو «نحن مع الطبقة العاملة الأوكرانية المعتدى عليها». فالبرجوازيون الأوكران أيضاً يتعرّضون للاعتداء من الدولة البرجوازية الروسية.
– مصالح الطبقات الشعبية في مختلف بلدان العالم هي مسألة أساسية بلا شكّ لدى أصحاب الفكر الاشتراكي. لكن حتى هذه المسألة تخضع للتنسيب ولمنطق الأولويات. إذ لا يمكن التفكير مثلاً في المساواة بين الطبقات الكادحة الصهيونية والطبقات الكادحة الفلسطينيّة، كما لا يمكن التعاطف مع طبقة عاملة مهيمَن عليها ثقافياً (مثل الطبقة العاملة الأميركية) لطالما ساندت أو صمتت عن/ أو أفادت من غزو دولتها البرجوازية لبلدان العالم، ولا النظر بالطريقة نفسها إلى الطبقات الكادحة في بلدان الجنوب (التي تعاني التفقير والإذلال القومي إلى جانب استغلال الرأسمالية المحلية التابعة للمراكز الإمبريالية) والطبقات الكادحة في بلدان الشمال الإمبريالي (التي تعاني الاستغلال الرأسمالي لكن مقابل أجور وخدمات اجتماعية معقولة بفضل الرّيع الإمبريالي الذي تحصّله برجوازيّاتها من بلدان الجنوب).
– بالنسبة إلى الاشتراكيّين، المسألة الرئيسية في التحليل يفترض بتقديري أن تكون السعي نحو الشروط الموضوعية والذاتية الأنسب لقيام ثورات متتالية تقضي على النظام الرأسمالي وتبني على أنقاضه الاشتراكية في مختلف أرجاء العالم. ولا شكّ في أنّ تحليل لينين بأنّ بلدان الجنوب (المستعمرة وشبه المستعمرة) هي «الحلقة الأضعف في السلسلة»، بما يرشّحها لاحتضان هذه الثورات، ما زال قائماً. وهذا ما يتطلبّ بلا شكّ في مرحلة أولى حصول حدّ أدنى من توازن القوى العالمي، بما يسمح لدول الجنوب التي تصل فيها أنظمة اشتراكية ثورية باللعب على التناقضات وحماية تجربتها وتطويرها ونشرها. والمعلوم أنّ الصين وروسيا هما من أكثر الدول المرشّحة لتعديل ميزان القوى مع الإمبرياليات الغربية المهيمنة.
– لا معنى للشرط السابق ذكره من دون حصول ثورات تقودها قوى اشتراكية. حصول هذا التعديل في ميزان القوى لن يؤدّي آلياً إلى انتهاء المنظومة الرأسمالية المعولمة، بل قد ينتهي الصراع بين القوى الإمبريالية القديمة والصاعدة إلى توافقات جديدة على حساب بلدان الجنوب.
– يجب وضع هذه الحرب في سياقها العامّ: هي ردّة فعل روسيّة على استمرار القوى الإمبريالية الغربية (وذراعها العسكرية حلف الناتو) بقيادة الولايات المتحدة في محاصرة روسيا، بهدف منع تحوّلها إلى قوّة عظمى من جديد. والنظام الأوكراني هو بيدق بيد هذه القوى الإمبريالية التي دفعته إلى المخاطرة واستفزاز النظام الروسي بطلبه «الانضمام إلى الناتو». وقد تكون هذه الحرب بمثابة الفخّ الذي استدرجت إليه روسيا من أجل استنزافها ومنعها من التحوّل إلى قوّة إمبريالية صاعدة كما يصبو إليه قادتها.
– ما سبق ذكره لا يجب أن ينسينا الطبيعة البرجوازية والرجعية لنظام بوتين. فهو لا يواجه الناتو من أجل إرجاع الاتحاد السوفياتي واستئناف النضال من أجل نظام اشتراكي عادل يخلّص البشرية من شرور الرأسمالية، بل هو يكافح من أجل استرجاع أمجاد الإمبراطورية الروسيّة ويسعى لأن يكون للبرجوازية الروسية نصيب أكبر من «كعكة العالم» الذي تحتكره البرجوازيات الغربية عموماً.
– رغم الطبيعة القومية الرجعية لهذا النظام، نجاح روسيا في تعديل ميزان القوى العالمي يمكن أن يمثّل متنفّساً لبلدان الجنوب، التي قد تشهد اندلاع ثورات في المرحلة المقبلة. لكن حتى هذا مشروط بتمكّن بلدان الجنوب (خاصة في منطقتنا العربية) التي تنجح فيها الثورات ذات القيادة الاشتراكية الوطنية، من بناء تكتلات إقليمية وازنة قادرة على التفاوض والمناورة. وقياساً على ذلك، ينطبق التحليل نفسه إقليمياً على النظام الإيراني الذي يوسّع ـــ رغم شوفينيّته ومحافظته ــــ من خلال صراعه مع الكيان الصهيوني باب الخيارات الممكنة للشعوب العربية.
– رغم الاقتناع بالطبيعة الرجعية العميلة للنظام الأوكراني، فإنّه لا يجب الموافقة على التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا وانتهاك سيادتها والعمل على احتلال عاصمتها وتغيير نظامها. فمن يقبل بذلك اليوم في أوكرانيا، لن يستطيع رفضه غداً عندما يأتي دوره. وتغيير الأنظمة مسألة تخصّ الشعوب وحدها.
– إن كان لهذه الحرب من منافع، فهي بلا شكّ فضحها (مجدّداً) لعمق نفاق المراكز الإمبريالية الغربية وازدواجية معاييرها. فما هو ممنوع اليوم ومدان بالنسبة إلى روسيا، كان وما زال مباحاً ومتاحاً لأميركا والكيان الصهيوني في فلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.
– أوضحت هذه الحرب بعد مرور أسبوع واحد على اندلاعها مدى تهافت الخطاب الليبرالي الغربي وزيفه. فإلى جانب تنكّر الدول الغربية لخطابها المخاتل عن رفض أسلوب المقاطعة (عندما تستعمله شعوبنا ضدّ الكيان الصهيوني المحتلّ وحروبه)، رأينا جامعات واتحادات دولية رياضية ومؤسسات فنية تقاطع روسيا من دون تمييز بين حكومة وشعب. كذلك، نرى درجة الشراسة التي يمكن أن يبلغها حصار القوى الإمبريالية الغربية. إذ رأينا الشركات الرأسمالية الغربية تنسحب من مشاريع مشتركة في روسيا («شال» و«بي بي» في مجالات الطاقة مثلاً). بل وصل الأمر حتى بشركات الإنترنت (فايسبوك وإنستغرام وتويتر وغوغل) إلى حجب المحتوى الروسي. كذلك، رأينا كيف أنّ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لم يتردّدا في تخصيص مساعدات عاجلة لأوكرانيا (من دون شروط مجحفة أو طلب «إصلاحات مؤلمة» كما اعتادا فعله مع بلدان الجنوب).
– عن فايسبوك
(*) كاتب تونسي
نعوم تشومسكي (*)
مسؤولية التأزم في أوكرانيا
الحل الأمثل لسلامة أوكرانيا (والعالم) أن يكون على شاكلة الحياد النمسوي/ الإسكندنافي الذي مورس خلال الحرب الباردة، ما كان يُسمح لهذه البلدان بالانتماء إلى أوروبا الغربية على هواها، من دون السماح بنشر قواعد أميركية على أراضيها. قواعد كانت ستُعتبر تهديداً لها ولروسيا. بالنسبة إلى الصراعات الداخلية الأوكرانية، يوفّر اتفاق «مينسك 2» إطاراً عاماً. كانت واشنطن قد تعهّدت لغورباتشوف «بأنّ الحلف الأطلسي لن يتوسّع ولو بوصة واحدة شرقاً»، وهو العهد الذي أخلفه كلينتون سريعاً، وبوش بإفراط. لم يكن ليتغيّر شيء، حتى لو تحوّل العهد الشفوي إلى وثيقة موقَّعة. فمرافعة الولايات المتحدة، هنا، لا ترقى حتى إلى مستوى الكوميديا. للولايات المتحدة احتقار مطلق للمبادئ التي تتغنّى بها. وهو ما يؤكده التاريخ الراهن مرة أخرى بطريقة فُرجوية. المشكل، بالنسبة إلى واشنطن، أعمق: كل حلول إقليمية تشكل تهديداً حقيقياً لدور الولايات المتحدة الدولي. وهو قلق ما انفك يتزايد منذ الحرب الباردة. فهل بوسع أوروبا أن تلعب دوراً مستقلاً في الشؤون الدولية؟ هل بوسعها أن تسير على خط ديغول، مع فكرة عن أوروبا الممتدة من البحر الأطلسي إلى جبال الأورال، وهي الفكرة التي أعاد غورباتشوف إحياءها في مرافعته، خلال 1989، عند حديثه عن «بيت أوربي مشترَك»، و«فضاء اقتصادي فسيح من البحر الأطلسي إلى الأورال»؟.
لم يكن، ساعتئذ، التفكير ممكناً في هذه الرؤية الواسعة لغورباتشوف، بوجود نظام أمني أوروآسيوي من لشبونة حتى فلاديفوستوك، ومن دون تكتلات عسكرية. وهي فكرة تم رفضها بالمطلق خلال المفاوضات، منذ ثلاثين سنة، بعد تصفية ما بعد الحرب الباردة. هو الأمر نفسه في المواجهة مع الصين: خرق الصين للقانون الدولي في البحار المجاورة، يطرح مشكلات جدية، رغم أن الولايات المتحدة، كقوة ملاحية، وباعتبارها البلد الوحيد الذي يرفض المصادقة على القانون الملاحي للأمم المتحدة، ليست في موقف قوة يسمح لها بمصارعة الصين.
في نظام مبني على القوانين، الولايات المتحدة هي من يصوغ القوانين.
لا أظن أن الولايات المتحدة ابتكرت طرقاً جديدة في الوحشية الإمبريالية الغربية. يكفينا النظر إلى أسلافها المباشرين في السيطرة على العالم. الغنى والسطوة العالمية للبريطانيّين مُتَأَتِّيَانِ من القرصنة (شخصيات مُؤَسْطَرَة كالسير فرانسيس دْرِيْكْ)، من نهب الهند بالمكائد والعنف، من الاستعباد البغيض، من أكبر شركة للمتاجرة الدولية بالمخدرات وأفعال أخرى تجاوزها «بهاءً»؛ فرنسا ليست أقل شأناً. أما بلجيكا، فقط حطمت الرقم القياسي في ما يخص الجرائم المروعة.
– عن موقع investigaction.net
(*) عالم لغويات أميركي وأهم دارسي الخطاب السياسي المعاصر
إدوارد سعيد (*)
خيانة المثقّف… لا مقاومةَ من دون ذاكرة
لا مقاومةَ من دون ذاكرة ومن دون قيم كونية. فإذا كان التطهير العِرقي شرّاً في يوغوسلافيا — من سيشكك في ذلك؟ —، فهو أيضاً شرٌّ في تركيا، في فلسطين في أفريقيا وفي أماكنَ أخرى. والأزمات لا تتوقف أبداً عندما تتوقف CNN عن تغطيتها. وإذا كانت الحرب قاسية ومكلفة، فهي كذلك، سواء كان الطَّيَّارون الأميركيون على ارتفاع 5000 متر أو لا. وإذا كانت الديبلوماسية دوماً أحسن من الوسائل العسكرية، فلا ينبغي إذن التضحية بها حتى عندما لا تكون الضحية من الجنس الأبيض ولا أوروبية.
تبدأ المقاومة لدينا، في وجه قوَّة لنا عليها سطوةٌ كمواطِنين. عندما يتم تمويهُ الوطنية في شكل نزعة قومية لتدَّعيَ الخضوع لإجراءٍ أخلاقي، وعندما تضع الإخلاصَ تجاه أُمَّتِها فوق كل اعتبار، بحيث يصير هذا الإخلاصُ أقوى من الوعي النقدي، فإن خيانةَ المثقفين وإفلاسهم الأخلاقي يصيران في حكم القضاء المبرَم.
– من مقالة بالعنوان نفسه، نُشِرَتْ في «لوموند ديبلوماتيك» (الطبعة الفرنسية، آب/ أغسطس 1999، في سياق القصف الأطلسي الممنهَج لصربيا)
(*) مفكر فلسطيني (1935 – 2003)، رائد الدراسات المابعد-كولونيالية والدراسات الثقافية مع كتابه «الاستشراق»
هادي العلوي (*)
الجهل بالتاريخ
الجاهل قد يكون مثقفاً كبيراً، والأمّي إذا نظرناه في غِرَارِيَّةِ الفرد العادي قد يكون أصحّ وعياً من المثقف الكبير، فالأمية لا ترادف الجهل، بل قد تجد ترادفاً بين الجهل والثقافة. الأمي هو الفرد العادي، لا يقرأ ولا يكتب. والجاهل قد يقرأ ويكتب ويكون له نصيب من الثقافة، لكنه يُسيء فهم حقائق الأشياء، ويفتقر إلى الوعي الاجتماعي والسياسي. ويصدر عن الجاهل المثقّف من التصرفات والأفكار الضارة أكثر ما يصدر عن الأمي. وقد تحدّثت عن الثوابت الثلاثة عند الأميين. وهي تشكل نقاط وعي ومؤثرة وعميقة في المجتمع. وهذه تجتمع في الجماهير الأمية، وقلّما تجدها مجتمعة في الوسط الثقافي. وقد ميّزت الفلسفة الإسلامية بين مرتبتين من الجهل، هما الجهل البسيط، والجهل المركب.
معنى الأول، أن لا تفهم شيئاً. ومعنى الثاني، أن تفهم أشياء مغلوطة. وهذا الأخير هو ما أقصده بجهل المثقف الذي يُسيء فهم الأشياء رغم اشتماله على المعرفة. ولو أردنا متابعة جهالات المثقفين في العصر الحاضر سواء في الشرق أو الغرب، لوقفنا على حقيقة ما أريد إثباته.
برتراند رسل، أعظم فلاسفة القرن العشرين، دعا سنة 1947 الولايات المتحدة الأميركية إلى قصف الاتحاد السوفياتي بالقنابل الذرية للقضاء عليه قبل أن يمتلك القنبلة الذرية. أيُّ جهلٍ أشد من هذا الجهل الذي يرتكبه فليسوف كبير، حين يدعو إلى إبادة شعوب بكاملها من أجل بقاء حضارته الغربية؟
برتراند رسل أيضاً ذهب في الثلاثينيات إلى الصين، ضمن حملة غربية لاستعمار الصين ثقافياً. وفي كتابه الهام جداً «تاريخ الفلسفة الغربية»، شطب رسل على الرشدية اللاتينية التي شغلت أربعة قرون من تاريخ أوروبا. والدافع عنصري. هذه تصرفات أكبر فلاسفة القرن العشرين!
ألا يحق لي الحديث إذن عن الجهل المركَّب للمثقفين؟ والجهل الثقافي لا يتمثل فقط في السلوكيات الجاهلة، بل في عدم معرفة حقيقيّة لأمور كثيرة يُفترض أن لا يجهلها أهل المعرفة. والجهل عند مثقّفينا المعاصرين يجمع بين جهل السلوك وجهل العقل. وأكثر ما يجهله مثقّفونا هو التاريخ.
■ ■ ■
عندما قسَّمتُ الثقافة المعاصرة إلى ثقافة غربية وثقافة حديثة، وأخذت بالحديثة ورفضت الغربية، فهذا يعني أخذ الكثير ممّا هو معنون كفكر غربي لكنه حديث، وميزته عن الفكر الغربي بخصائصه المعادية للآخر، سواء كان هذا الآخر جغرافيا سياسية أم جغرافيا اجتماعية تنتمي إلى معسكر الفكر نفسه «الطبقاتُ العاملة في الغرب».
وأودّ الإشارة أيضاً إلى الفكر المعارض في الغرب، وهذا قد يكون معارضاً في نطاق السياسة الداخلية وهو كثير، ومعارضاً في السياسة الخارجية وهو قليل. نعوم تشومسكي مثلاً الذي ينتمي إلى خط الثقافة الحديثة خارجاً من قيود الثقافة الغربية. الفكر المعارض في الغرب قام ويقوم بدور عظيم في إصلاح المجتمع الغربي وتخليصه من آثار الهمجية. وعلماء الاجتماع الغربيون ساهموا بدور عظيم في تحسين وضع السجون الأوروبية التي كانت حتى القرن التاسع عشر مسالخ بشرية، لكن هؤلاء العلماء أنفسهم لم يطلقوا صيحة واحدة ضد المسالخ البشرية التي يصنعها الغربيون في القارات الملونة. أعداد منهم كانوا ولا زالوا يصدرون عن حالة انشقاق فردي، فيخرجون عن السائد.
– هادي العلوي: «حوار الحاضر والمستقبل» (1999).
(*) مفكر ومؤرخ ولغوي عراقي (بغداد، 1932 – دمشق، 1998)؛ باحث منقِّب في التاريخ العربي ـــ الإسلامي بمنهجية ماركسية، على خطى معلمه العلَّامة الشهيد حسين مروة.
* عناوين النصوص من وضع التحرير
الاخبار
———————————

ما الذي يعنيه الدفاع عن أوروبا؟/ سلافوي جيجيك
يعود الفيلسوف السلوفيني، سلافوي جيجيك، في هذه المقالة لانتقاد ازدواجية المعايير الأوروبية حيال اللاجئين. وهو يرى أن الطريق الأمثل لدفاع أوروبا عن نفسها يتمثل بتقديمها خيارات أفضل من تلك التي تقدمها روسيا أو الصين.
نص المقالة الأصلية: “What does Defending Europe Mean”
ترجمة: مهيار ديب
بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت الحكومة السلوفينيّة على الفور جاهزيتها لاستقبال آلاف اللاجئين الأوكرانيين. وأنا، كمواطن سلوفيني، لا أشعر بالفخر فحسب، بل بالعار أيضًا.
حين سقطت أفغانستان بيد “طالبان” منذ ستة أشهر، رفضت هذه الحكومة ذاتها استقبال اللاجئين الأفغان، بحجة أنّه من الحريّ بهم أن يبقوا في بلادهم ويقاتلوا. ومنذ بضعة أشهر، حين كان آلاف اللاجئين – معظمهم من كرد العراق – يحاولون دخول بولندا عن طريق بيلاروسيا، عرضت الحكومة السلوفينية المساعدة العسكرية دعمًا لجهود بولندا الدنيئة في إبعادهم، زاعمةً أنّ أوروبا تتعرض لهجوم.
لقد برز في أرجاء المنطقة نوعان من اللاجئين، توضح تغريدةٌ للحكومة السلوفينية في الخامس والعشرين من شباط المنصرم، الفارق بينهما: “يأتي اللاجئون الأوكرانيون من بيئة تختلف تمامًا في معناها الثقافي والديني والتاريخي عن تلك التي يأتي منها الأفغان”. وبعد احتجاج صارخ، حُذفَت التغريدة بسرعة. لكن الحقيقة الفاضحة انجلت: يجب أن تحمي أوروبا نفسها من غير الأوروبيين.
هذه المقاربة سوف تكون كارثية بالنسبة إلى أوروبا في الصراع العالمي الجاري على النفوذ الجيوسياسي. وهو صراع تصوغه وسائل إعلامنا ونُخبنا على أنّه نزاع بين عالم “ليبرالي” غربي وعالم “أوراسي” روسي، متجاهلة المجموعة الأكبر من البلدان – في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا – التي تراقبنا عن كثب.
حتى الصين ليست مستعدة لدعم روسيا بشكل كامل، على الرغم من أنَّ لديها خططها الخاصة. وفي رسالة إلى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد يوم من شنّ روسيا غزوها لأوكرانيا، قال الرئيس الصينيّ شي جين بينغ إنَّ الصين مستعدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين “في ظل وضع جديد”. وثمّة خشية من أن تستغل الصين “الوضع الجديد” لـ”تحرير” تايوان.
ما يجب أن يقلقنا الآن هو أنَّ التطرف الذي نشهده، لا سيما لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس تطرفًا بلاغيًا فحسب. وقد حسب كثير من اليساريين الليبراليين، الموقنين أنَّ كلا الطرفين يعلمان أنَّهما لا يستطيعان تحمّل كلفة حرب كاملة، أنَّ بوتين كان يخادع عندما حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. وحتى عندما وصف بوتين حكومة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بأنّها “عصابة من المدمنين والنازيين الجدد”، ظنَّ معظمهم أنَّ روسيا لن تحتل سوى “الجمهوريتين الشعبيتين” الانفصاليتين اللتين يحكمهما انفصاليون روس مدعومون من الكرملين، أو أنّها، على الأكثر، سوف توسع هذا الاحتلال ليطال كامل منطقة دونباس شرقيّ أوكرانيا.
الآن، إنَّ بعضًا ممن يدعون أنفسهم يساريين (ولستُ منهم) يلقون باللوم على الغرب لحقيقة أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن كان محقًّا بشأن نوايا بوتين. والحجة معروفة: كان “الناتو” يطوّق روسيا رويدًا رويدًا، مهيّجًا الثورات الملوّنة في الخارج الروسيّ القريب، ومتجاهلًا المخاوف المحقّة لبلدٍ كان الغرب قد هاجمه في القرن الأخير.
ثمّة، بالطبع، جانب من الحقيقة هنا. لكن الاقتصار على قول ذلك وحده يكافئ التبرير لهتلر بإلقاء اللوم على “معاهدة فرساي” الظالمة. والأسوأ، أنّه يقرّ بأنَّ للقوى العظمى الحقّ في مناطق نفوذ على الجميع أن يخضعوا لها في سبيل الاستقرار العالمي. واعتبار بوتين أنّ العلاقات الدولية هي تنافس قوى عظمى، ينعكس في زعمه المتكرر أن لا خيار أمامه سوى التدخل العسكري في أوكرانيا.
هل هذا صحيح؟ هل الفاشية الأوكرانية هي المشكلة حقًا؟ الأجدر توجيه السؤال إلى روسيا بوتين. إنّ منارة بوتين الفكرية هي إيفان إيلين الذي أُعيد طبعُ أعماله وأُتيحت للموظفين والمجنّدين. وبعد طرد إيلين من الاتحاد السوفيتي في أوائل عشرينيات القرن الماضي، راح يدافع عن طبعة روسية من طبعات الفاشيّة: الدولة باعتبارها جماعة عضوية يقودها عاهل أبوي، تتمثل فيها الحرية بمعرفة كل امرئ مكانه. والهدف من الاقتراع عند إيلين (كما عند بوتين) هو التعبير عن الدعم الجمعي للزعيم، وليس جعله شرعيًا أو اختياره.
يتبع ألكسندر دوغين، فيلسوف البلاط لدى بوتين، خطا إيلين، مضيفًا بعض الزخرفة النسبية التاريخية ما بعد الحداثية: “ما تُدعى الحقيقة هي مسألة إيمان كلّها. ولذلك نؤمن بما نفعل، نؤمن بما نقول. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتعريف الحقيقة. ولذلك لدينا حقيقتنا الروسية الخاصة التي يجب أن تتقبلوها. إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد أن تبدأ حربًا، عليكم أن تدركوا أن الولايات المتحدة لم تعد سيّدًا أوحد. وبالنظر إلى الوضع في سوريا وأوكرانيا، تقول روسيا: ’لا، لم تعودوا الرأس بعد الآن‘. أمّا السؤال من يحكم العالم، فالحرب وحدها هي التي يمكن أن تقرر ذلك”.
ولكن ماذا عن الشعبين في سوريا وأوكرانيا؟ هل يمكنهما أيضا اختيار حقيقتهما الخاصة أم أنهما مجرد ساحة معركة لحكّام العالم المزعومين؟
فكرةُ أنَّ لكلّ “طريقة من طرق الحياة” حقيقتها الخاصة هي ما يجعل بوتين محببًا لدى شعبويين يمينيين مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أثنى على غزو روسيا لأوكرانيا باعتباره ضربًا من “العبقرية”. والشعور متبادل: عندما يتحدث بوتين عن “التطهير من النازية” في أوكرانيا، يجب أن نبقي في الأذهان دعمه لجبهة ماري لوبين الوطنية في فرنسا، ورابطة ماتيو سالفيني في إيطاليا، وغير ذلك من الحركات النازية الجديدة الفعلية.
ليست “الحقيقة الروسية” سوى أسطورة مريحة لتبرير رؤية بوتين الإمبراطورية، وأفضل طريقة تواجهها بها أوروبا هي مدّ جسور مع البلدان النامية والناشئة التي لدى كثير منها قائمة طويلة من المظالم المحقّة ضد الاستعمار والاستغلال الغربيين. لا يكفي “الدفاع عن أوروبا”. والمهمة الحقيقية هي إقناع البلدان الأخرى بأنَّ الغرب يمكنه أن يقدّم لها خيارات أفضل من تلك التي يمكن أن تقدمها روسيا أو الصين. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تغيير أنفسنا باجتثاث الاستعمار الجديد بلا رحمة، حتى حين يأتي مرزومًا على هيئة مساعدة إنسانية.
هل نحن مستعدون لأن نثبت أننا بالدفاع عن أوروبا نناضل من أجل الحرية في كلّ مكان؟ إنَّ رفضنا المشين معاملة اللاجئين على قدم المساواة يرسل للعالم رسالة مختلفة تمامًا.
———————
روسيا واليسار في المنطقة العربية/ جلبير الأشقر
توضيح لا بدّ منه بادئ ذي بدء. في التصنيف التقليدي للفلسفة السياسية، تُصنَّف في اليسار الأطراف التي تشكّل المساواة الاجتماعية القيمة الفلسفية الرئيسية لديها، في حين أن الليبرالية تضع في الصدارة الحرية السياسية والمساواة في الحقوق. والحقيقة أن اليسار تطوّر تاريخياً من رحم الليبرالية، من جناحها اليساري الذي مثّله خير تمثيل الفيلسوف الفرنسي جان-جاك روسو. فاليسار بالمعنى الأصلي هو مَن يُضيف إلى القيمتين الليبراليتين المذكورتين قيمةَ المساواة الاجتماعية، على غرار ما نجده لدى كارل ماركس وفريدريش إنغلز أو في تجربة كومونة باريس (1871). بيد أن المسار التاريخي ولّد أيضاً قسماً من اليسار شطّ عن القيمتين الليبراليتين ليسحق الحريات، بدءاً من حكومة روبسبيار خلال الثورة الفرنسية (94-1793) وصولاً إلى الحكم الستاليني في الاتحاد السوفييتي الذي وصل به سحقه للحريات وللحقوق السياسية إلى إعادة انتاج نظامٍ من اللامساواة الاجتماعية تتربّع على السلطة فيه فئة بيروقراطية ميسورة.
ومع ذلك، بقيت الستالينية تنادي بالمساواة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية ولو من باب الحرب الأيديولوجية، فرأينا أتباعها من أحزاب شيوعية تدخل في حالة شبيهة بانفصام الشخصية، تدافع عن القيمتين الليبراليتين في الدول المنتمية إلى المعسكر الغربي وتؤيد الدكتاتورية البيروقراطية الشمولية في الاتحاد السوفييتي والدول الدائرة في فلكه. وفي أولى السنوات اللاحقة لانهيار الاتحاد السوفييتي، كانت قوى اليسار بشتى أطرافها تميّز بين مناهضتها للإمبريالية الأمريكية وتمسكّها بالقيم التقليدية. فعندما قامت الولايات المتحدة، ومعها حلفٌ عريض شمل سوريا حافظ الأسد، بشنّ هجومها الأول على العراق في عام 1991، ميّزت قوى اليسار بمعظمها بين شجبها للعدوان وموقفها من نظام صدّام حسين الغارق في الاستبداد والرشوة والفساد.
وفي المقابل، رأينا شططاً لدى بعض الأطراف غير الشيوعية المدّعية لليسار، بل المدّعية للماركسية-اللينينية (وماركس ولينين منها براء)، وهي بوجه عام أطراف نتجت عمّا سمّي «تمركس» (أي تبنّي الماركسية) بعض الجماعات القومية في المنطقة العربية في نهاية الستينيات من القرن المنصرم. هذه الأطراف، تمشياً مع الارتهان المادي الذي نسجته مع الأنظمة العربية المنبثقة من التيّار القومي، أي عراق صدّام حسين وسوريا آل الأسد وليبيا القذّافي، ابتعدت عن كافة قيم اليسار التاريخية في تعاملها مع هذه الأنظمة المضادة للحرية والحقوق والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، وأبقت على مبدأ واحد هو معاداة الولايات المتحدة.
وهي معاداة تنسجم مع موقف الأنظمة المذكورة، فبالرغم من ادّعاء هذه الأطراف أنها تتبنّى «مناهضة الإمبريالية»، هي في الحقيقة مناهِضة للإمبريالية الأمريكية حصراً، تتعامى عن كون روسيا فلاديمير بوتين دولة قائمة على رأسمالية فاحشة، أسوأ بشتّى المقاييس من الرأسماليات الغربية، ودولة إمبريالية بامتياز تَرسّخ حكمُها من خلال سحق شعب الشيشان داخل حدود «الاتحاد الروسي»، ثم انتقل إلى السعي وراء استرجاع بعض ما سيطرت عليه الإمبراطورية الروسية في زمن القياصرة.
وها أن أدعياء اليسار هؤلاء يُبدون مودّة إزاء قيصر روسيا الجديد في غزوه الإمبريالي لأوكرانيا، وهي مودّة تتراوح بين نقد غزو أوكرانيا من طرف الشفاه مع تصويب كافة الأسهم ضد أمريكا، في أحسن الحالات، وبين التذيّل لموسكو على غرار رئيس المحمية السورية للإمبراطورية الروسية. وقد باتوا في تبعيتهم لنظام آل الأسد أسوأ بعد من أتباع النظام الثيوقراطي الإيراني، الذي التزم الحذر ولم يؤيد الغزو الروسي، لاسيما أنه يعلم مدى تواطؤ الحكم الروسي مع الدولة الصهيونية ضدّه وفي الساحة السورية بالذات. أما الأحزاب الشيوعية البارزة في المنطقة العربية، فقد شجبت الغزو الروسي لأوكرانيا على العموم، وهي تدين الولايات المتحدة في الآن ذاته كما ينبغي أن يكون الموقف السليم.
فقد أصدر الحزب الشيوعي العراقي، في بيانه بتاريخ 25/2، موقفاً يقول: «إن شعوب العالم التي لم تتعاف بعد من جائحة كورونا وآثارها الوخيمة، صُدمت على نحو واسع بهذا الاستسهال لخرق القانون الدولي وسيادة الدول، وهو ما قامت به أمريكا وحليفاتها مرّات كثيرة سابقاً، ويتكرّر الآن في هذه العمليات العسكرية الروسية، في حين يتوجب الالتزام باحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحرص على السلام والاستقرار في العالم واحترام القواعد والأعراف الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة.»
وأتى الموقف الأوضح من الحزب الشيوعي السوداني. فقد أصدر بياناً بتاريخ 27/2، بدأ على النحو التالي: «إن الغزو الروسي لجمهورية أوكرانيا يفضح الصراعات بين القوى الإمبريالية لبسط نفوذها والاستيلاء على الموارد في القارة الأوروبية والعالم. ورغم الذرائع التي يستخدمها الطرفان – روسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو من جهة أخرى – إلا أن الغزو الروسي وما صاحبه من اتهامات أتى نتيجة المنافسة الإمبريالية بين الجبهتين.» كما جاء في نهاية البيان: «إن الحزب الشيوعي السوداني إذ يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا، يدين كذلك استمرار التحالف الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة في تأجيج التوتر والحرب وتهديد السلام والأمن العالميين.»
وربّما كان السبب الرئيسي الذي يفسّر الوضوح الأكبر في موقف الحزب السوداني أنه يناضل في موقع مميّز لإدراك حقيقة الإمبريالية الروسية، إذ إن روسيا بوتين ليست متحالفة مع مصر السيسي وإمارة بن زايد في دعم خليفة حفتر في ليبيا وحسب، بل هي أكثر الدول العظمى صراحةً في دعمها للطغمة العسكرية الانقلابية في السودان، وقد ربطت علاقة وثيقة، اقتصادية وعسكرية، مع أكثر الأطراف العسكرية السودانية رجعيةً، قصدنا بالطبع المجرم «حميدتي» الذي زار موسكو يوم بدء غزو أوكرانيا بالذات. وقد جاء في بيان الحزب تعليقٌ على ذلك يقول: «الحزب الشيوعي السوداني، في اتساق مع موقفه المبدئي في الحفاظ على سيادة السودان وإبعاده عن المحاور العسكرية، وإقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، يُدين زيارة سلطة انقلاب 25 أكتوبر، ومحمّد حمدان دقلو لروسيا، وينبّه إلى خطورة التوقيع على إقامة القاعدة العسكرية الروسية على البحر الأحمر، مما يجعل السودان في مرمى نيران الصراع بين أمريكا وروسيا ومرتزقتها (فاغنر) لنهب موارد السودان وأفريقيا مما يهدّد الأمن والسلم العالميين.»
*كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
—————————–
فضيلة الكذب في النظام الدولي الجديد/ أرنست خوري
في العنوان التكتيكي للحرب الروسية على أوكرانيا، ترّهات وكذب وإبحار في محاكمة النوايا بمصطلحات فصيحة لا تخفي خواء المعنى: إطاحة “الحكومة النازية” في كييف، وحماية الأوكرانيين الناطقين بالروسية في الشرق من “الإبادة”، وضمان منع تحوّل هذا البلد إلى “قاعدة أميركية” ممثلة بحلف شمال الأطلسي. لا داعي لشرح ما لا يُشرح. أما في العنوان بعيد المدى، فتصبح الكذبة بفخامة الاستراتيجيا: تغيير النظام الدولي وكسر الأحادية الأميركية وافتتاح زمن التعددية القطبية. والكذب في السياسة غير محصور في أي من أطراف ذلك المحور الطامح بإدخالنا جنة التعددية القطبية لا سمح الله. لا هو حكر على روسيا ولا الصين ولا إيران، لكنه عند هؤلاء، يكتسب نكهة خاصة. كارهو النظام الدولي الحالي يقولون إنهم يريدون إسقاطه لكسر الأحادية الأميركية وإنهاء حروبها. العودة إلى مسوغات تلك الحروب منذ انتهاء عصر الثنائية القطبية قد تتيح مقارنات بسيطة في إطار رصد بارومتر الكذب في حروب المحورين. في الذاكرة أربع حروب أميركية ــ أطلسية: يوغوسلافيا (1998)، أفغانستان (2001)، العراق (2003)، ليبيا (2011). في الحروب الأربع، أكذوبة واحدة كبيرة: العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. استنفر الثنائي الأميركي البريطاني كل أجهزته وإمكانياته وإعلامه (نيويورك تايمز خصوصاً) لكي يبتلع العالم تلك الأكذوبة، وهو ما لم يحصل. دراسات وتحقيقات وتقارير وصداع في الرأس لتكون الأكذوبة “مشغولة”، دسمة، فيها حرفية، يمكن تصديقها، تليق بأن تكون مبرراً مقنعاً لشن حرب العراق. الحرب الأميركية الفاشلة في العراق كانت بحجم أكذوبة كولن باول. أما حروب يوغوسلافيا (1998) وأفغانستان (2001) وليبيا (2011)، فقد حصلت بلا كذب. لمَ الكذب أصلاً؟ ألا يكفي وجود نماذج من صنف سلوبودان ميلوزيفيتش وتحالف بن لادن مع حركة طالبان، ومعمر القذافي لتبريرها؟ الأكذوبة الأميركية إياها، ما الذي حلّ بها؟ لجان تحقيق واعتزال للعمل السياسي واستقالات ومحاكمات ورؤوس كبيرة تطير ومحاسبة ولعنة لم تفارق صاحبها كولن باول حتى وفاته قبل أشهر. محاسبة تليق بما يُسمّى دولة فيها حقوق وديمقراطية وقانون، تتسبّب بالكوارث وترتكب الجرائم ولكن ثمّة من يحاسب في النهاية، وإن لم يعنِ ذلك تصحيح الخطأ وجبر أضراره.
هذا عن الأكذوبة الكبرى لعصر الأحادية القطبية الأميركية ـ الأطلسية. ماذا عن حروب المحور الذي ييشر بقرب تقاسمه النفوذ في العالم مع الغرب؟ ذاك المحور الروسي ــ الصيني ــ الإيراني حروبه تحصل بكذب ينساب كالنسيم، هكذا بلا تشكيك في الرواية الرسمية أو سؤال أو استفسار، بلا تدقيق من رأي عام ولا إعلام يفنّد ولا لجان تحاسب وتكشف الحقيقة وكيف اختُرعت الأكذوبة. الحرب على أوكرانيا غير موجودة أصلاً، فمن يستخدم مصطلح الحرب في روسيا معرض للسجن 15 عاماً، فهي “عملية عسكرية خاصة”. اسم فني لائق. ثم لماذا تصدّرت إيران بمليشياتها حفلة الدم في سورية؟ لحماية مقامات دينية. فلتتغيّر السردية: للحفاظ على وحدة الأراضي السورية. لا بد من قصة أكثر تماسكاً وجاذبية: لمحاربة الإرهاب. سؤال آخر عن حروب “المحور”: لماذا انضمت روسيا إلى قافلة قتلة الشعب السوري في سبتمبر/ أيلول 2015؟ تلبيةً لطلب تلقته رسمياً من الجمهورية العربية السورية. هكذا ببساطة وانتهى الأمر. فلاديمير بوتين وسيرغي لافروف والآخرون لا يخجلون. ينظرون بالكاميرا ولا يرف لهم جفن وهم يتقيّأون أكاذيبهم. ظل المذكوران يكرّران لأشهر كذباً بأن بلدهما لن يغزو أوكرانيا، وبقيا يجترّان أنها مجرد بروباغاندا أميركية. أما عند الطرف الآخر المسمى غرباً، فتُمسح الأرض بالمسؤولين داخل بلدانهم أولاً عندما يقترفون أكذوبة من هذا الحجم. في المقابل، المواطنون المحتجون على قرار الحرب في بلدان “المحور”، لهم السجن على الأقل، إن لم يكن القتل.
ضد حروب النظام الدولي المُراد تغييره، تمتلئ شوارع واشنطن ولندن وباريس بمئات آلاف المتظاهرين ضد حكوماتهم. هناك إعلام حر ووصول إلى المعلومة يتيح معرفة ما إذا كان ما تدعيه هذه العواصم كذباً أو حقيقة. أما في النظام الموعود بتعدديته القطبية مثلما تراه الصين وروسيا وإيران، فلا وجود للكذب، هناك صدق الخرافة والتخلف والقتل والتعذيب والقمع.
يحيا ذلك الكذب، واللعنة على هذا الصدق.
العربي الجديد
————————

القيصر وأحلام ما بعد أوكرانيا/ عبد الباسط سيدا
الأزمة المتدحرجة بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة ثانية، من أكثر الأزمات خطورة وجدّية منذ نهاية الحرب الباردة على أثر تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، إن لم نقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1939-1945، وهي أزمةٌ أعمق وأشمل مما تبدو عليه الآن، فالموضوع لا يقتصر على امتناع الولايات المتحدة أو الحلف الأطلسي عن تقديم ضمانات أنّ أوكرانيا لن تصبح مستقبلاً جزءاً من المنظومة الأطلسية الدفاعية، التي شملت منذ تفكّك الاتحاد السوفييتي 14 دولة من أوروبا الشرقية: إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، المجر، رومانيا، التشيك، سلوفاكيا، بلغاريا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية؛ وإنّما للموضوع علاقة برغبة روسية واضحة لاستعادة دور القوة العظمى على المستوى العالمي، فروسيا، التي كانت تعتبر نفسها في مرحلة الاتحاد السوفييتي القطب الثاني الندّ للقطب الغربي بقيادة الولايات المتحدة، فَقَدت الدور والوزن اللذين حظيت بهما سبعين عاماً، وذلك بعدما فقدت السيطرة على الدول التي تعدّها مجالها الحيوي؛ بل انفصلت عنها مجموعة من الجمهوريات ذات الحكم الذاتي لتصبح دولاً مستقلة، هذا على الرغم من أنّ غالبيتها ما زالت خاضعة للنفوذ الروسي من خلال الحكومات التي تحصل على دعم مباشر من موسكو لمواجهة التحرّكات الشعبية المناهضة لاستبدادها وفسادها.
لقد حاولت روسيا في مرحلة بوتين اعتماد الأيديولوجيا الأوراسية لتوسيع دائرة نفوذها، واستعادة مكانتها في الدول المحيطة بها، وهي الدول والمناطق التي اعتبرتها دائماً بمثابة حدائقها الخلفية. لكنّ المشكلة التي تعاني منها أنّ هذه الأيديولوجيا لا تقنع الأوروبيين ولا الآسيويين في الوقت ذاته، فالدول الأوروبية بصورة عامة، الغربية منها والشرقية، ترى في الاتحاد الأوروبي النموذج المقبول المعقول للعمل الجماعي بين الدول المستقلة بالفعل.
أما الدول الآسيوية المعنية المؤثرة، فإنّ غالبيتها ترى في الأيديولوجيا المعنية محاولة روسية أخرى للهيمنة والسيطرة، وما يعزّز هذا الإنطباع هو النزوع القومي الأرثوذكسي الروسي اللافت الواضح في خطابات بوتين وممارساته وأركان حكمه.
كان بوتين يراهن على ضعف الديمقراطيات الغربية، وانشغال الحكومات الأوروبية بالحسابات الانتخابية، واستعدادها لعقد الصفقات السرية والعلنية مع الأنظمة المستبدة من أجل تأمين المواد الأولية وأسواق التصريف، ومن ثم توفير مزيد من فرص العمل في الداخل، الأمر الذي من شأنه كسب الرأي العام وتعزيز فرص الفوز في الانتخابات.
كما كان يعلق الآمال على تنامي الحركات القومية العنصرية التي استلهمت من نظامه الكثير، بل استفادت منه بطرقٍ شتى؛ وفي الوقت ذاته، كان يركز على الصين، في محاولة منه لكسبها إلى جانبه، لا سيما أنّ لها، هي الأخرى، موقفاً من الموضوع التايواني الذي يتماثل في أوجه عدة مع موقف روسيا بوتين من أوكرانيا.
غير أنّ الموقف الغربي المتماسك، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو ضمن الحلف الأطلسي، والتنسيق التام بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بدّدا كلّ أوهام العظمة والقدرة على السيطرة من خلال القوة العارية التي تمثل الخلفية التي يمكن بناءً عليها فهم (وتفسير) جانب كبير من سلوكيات الرئيس الروسي بوتين وخططه، فبعد الضربة التدميرية القاصمة التي وجهها إلى غروزني في 1994 – 1995، وتدخله في جورجيا عام 2008، وأوكرانيا عام 2014، وسورية في عام 2015، ظنّ أنّ الباب قد أصبح مفتوحاً أمامه لالتهام أوكرانيا بالكامل والتوجّه نحو دول البلطيق، وربما بولندا وغيرها، الأمر الذي كان سيشكل تهديداً مباشراً لدول الشمال في أوروبا الغربية، وذلك كلّه سيضع الأنظمة الديمقراطية أمام التحدّيات الصعبة، من جهة إعطاء الدفعة للحركات اليمينية الشعبوية المتشدّدة التي لا تؤمن أصلاً بالقوانين والقواعد الديمقراطية، وإنّما تستغلها من أجل الوصول إلى السلطة؛ وكذلك من ناحية دعم الأنظمة المستبدة في العالم. بل وترويج ثقافة الاستبداد، وإشاعة فكرة قدرة الأنظمة الاستبدادية على تجاوز نقاط ضعف الأنظمة الديمقراطية ومثالبها.
الأنظار الغربية حالياً متركزة على الصين. هل ستتدخل لتضعف تأثير العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على روسيا؟ أم ستعطي الأولوية لمصالحها وتوجّهاتها التقنية والتجارية التي فتحت لها المجال والآفاق في مختلف أنحاء العالم؟ هذا في حين أنّ روسيا ركّزت على التقنيات العسكرية، واعتمدت الأسلحة الاستراتيجية وسيلة للتمدّد والتهديد بغية الوصول إلى مناطق عديدة، بما فيها مناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى أميركا اللاتينية، فروسيا على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة، سواء على صعيد النفط والغاز والمعادن أم على صعيد القدرات الزراعية والموارد البشرية المتخصّصة، ما زالت متخلفة قياساً إلى غيرها في ميدان الصناعات الحديثة، فهي تأتي في المرتبة الحادية عشرة أو الثانية عشرة اقتصادياً بعد الهند وكندا. ومن المرجّح أن تتسبّب مغامرتها الأوكرانية والعقوبات الصارمة التي ستعاني منها كثيراً في تراجع اقتصادها، الأمر الذي سيفاقم من مشكلاتها الداخلية، وهي مشكلاتٌ كبيرة في الأساس بفعل الفساد المنتشر، وجشع مجموعة من أثرياء المرحلة الانتقالية الذين راكموا ثرواتهم بفعل علاقاتهم المصلحية المثيرة للجدل مع المجموعة المهيمنة ضمن دائرة الحكم.
ستكون تداعيات الأزمة الأوكرانية كبيرة وقوية، ففي روسيا، وبعد تفاعل نتائج العقوبات القاسية، من المرجح أن تنشط الحركة المعارضة لبوتين، بعدما ثَبُت للداخل الروسي أنّ النزوع التوسعي العسكري والاستبداد الداخلي لم يؤدّيا سوى إلى تراجع مستوى الدخل وقمع الحريات. لكنّ المشكلة هنا أنّ القيادة الروسية الحالية لم تتخلّص بعد من النزوع الإمبراطوري بمعناه التقليدي، فهي ما زالت تخطّط وتعمل من أجل استعادة السيطرة المباشرة على الدول والشعوب التي كانت خاضعةً للإمبراطورية الروسية قبل الثورة الشيوعية وبعدها. وهي تعمل على شيطنة أيّ فعل معارض عبر وصمه بتهمة العمالة للغرب، فهاجس الانتقام من الغرب هو الذي يتحكّم بسلوكيات هذه القيادة واستعدادها، وما زال هذا الهاجس هو المحرّك الذي تتمركز حوله حملات الدعاية التي تشرف عليها القيادة المعنية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال وسائل التواصل.
فروسيا، عوض أن تأخذ بتجارب اليابان والألمان بعد الحرب العالمية الثانية، ما زالت تعيش المشاعر ذاتها التي كانت سائدة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الشروط القاسية التي فرضتها عليها دول الحلفاء في فرساي عام 1919؛ هذا مع فارق الحالتين. فألمانيا كانت قد هُزمت عسكرياً، في حين أنّ الاتحاد السوفييتي كان قد تفكّك داخلياً نتيجة تراكم عوامل الفساد، ومساوئ الإدارة وتراكم تبعاتها على مدى العقود. وقد جاء هذا التفكّك بعد الإصلاحات التي دعا إليها غورباتشوف في سياق عمليتي البيريسترويكا والغلاسنوست، وهي إصلاحاتٌ لم تجد طريقها إلى النور بفعل تحرّكات لجنة الطورائ، ومن ثم الانقلاب الذي جاء بيلتسين، وشاركت فيها مجموعة من القيادات التي كان غورباتشوف يدعو أصلاً إلى إبعادها ومحاسبتها. وما حصل بعد ذلك أن تلك القيادات استمرّت، وبعضها انتقل إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي ذات الحكم الذاتي، لتصبح على رأس الدول المستقلة التي ما زالت تعيش واقع الفساد والاستبداد، فتجربة غورباتشوف لم تأخذ فرصتها، بل اتهم صاحبها بأقذع الصفات، سواء من المستفيدين من المرحلة السوفييتية أم من الذين استغلوا واقع انهيار الاتحاد السوفييتي ليؤدّوا أدواراً جديدة تتناسب مع المتغيرات والمعطيات المستجدّة. وهذا يذكّرنا بواقع ما حدث لألكسندر دوبتشيك في تشيكوسلوفاكيا نتيجة الغزو السوفييتي لبلاده عام 1968، والقضاء على التجربة الإصلاحية التي ربما كانت، في حال نجاحها، إنقاذاً لروسيا نفسها.
هل ستقنع الصين عدوتها العقائدية السابقة وصديقة الحاجة الراهنة بإمكانية العودة إلى موقف القطب المؤثر في النظام العالمي الجديد، اعتماداً على الاقتصاد والتقنية والبحث العلمي السلمي؟ أم أنّ القيصر الجريح سيتابع ما بدأ به، حتى ولو أدرك، في قرارة نفسه، أنّه سيخفق في مغامرته الأوكرانية المكلفة كما أخفق نابليون قبله في مغامرته الروسية؟ لكن، في جميع الأحوال، تظلّ الحروب، بكلّ أنواعها، بشعة قاسية، تدمّر الاجتماع والعمران وتحطّم الإنسان، وتبقى الدبلوماسية العقلانية أفضل الوسائل لحلّ النزاعات.
العربي الجديد
————————–
لماذا لا ينبغي أن ينتصر بوتين؟/ علي أنوزلا
من المرجّح أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سينتصر في معركته ضد أوكرانيا، فكل المعطيات العسكرية تؤكّد أن موازين القوى بين روسيا وأوكرانيا، حتى بالدعم الغربي الذي تتلقاه، غير عادلة، لذلك من غير المنتظر أن يخسر الحرب في ساحة المعركة. لكن المؤكّد أنه سيخسر الحرب على المدى الطويل، حتى لو بسط سيطرة قواته على كل الأراضي الأوكرانية بقوة النار والحديد. وهنا بعض مؤشرات هذه الخسارة المرتقبة: أولها تلك التي لحقت بسمعة الجيش الروسي، الذي يصنّف ثاني أقوى جيش في العالم بعد جيش الولايات المتحدة، فقد أبانت عشرة أيام من حرب أوكرانيا افتقاده إلى التخطيط والاحترافية، رغم امتلاكه أحدث الأسلحة وأقوى العتاد، ففي الخمسة أيام الأولى من الحرب توفي 500 جندي روسي في ساحة المعركة، أي بمعدل سقوط مائة جندي يوميا، وهذا فقط حسب ما اعترفت به السلطات العسكرية الروسية! وخلال هذه الأيام العشرة فقط، نقلت كاميرات وسائل الإعلام صور أرتال من الدبابات والمركبات العسكرية الروسية محطّمة تلتهمها النيران، وتابع المشاهدون صور سقوط طائرات ومروحيات عسكرية روسية تحولت إلى كتلة من اللهب، تشبه التي تزخر بها الألعاب الإلكترونية، مع فارق كبير أن صور احتراق الطائرات وانفجار المروحيات الروسية حقيقة وليست افتراضا. الخسارة الأولى، إذن، هي خسارة هيبة ثاني أقوى جيش في العالم بالرغم من أنه يمتلك أكبر ترسانة نووية في التاريخ.
خسارة بوتين الثانية، ذات طبيعة دبلوماسية، وهذه من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها عندما دخل حربا واسعة ضد الغرب بدون حلفاء أقوياء، أو بالأحرى بدون حلفاء أصلا، كما أظهرت ذلك نتائج التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف العدوان الذي أيدته 140 دولة، وامتنعت عن التصويت ضده 35 دولة من بينها دول معروفة بقربها من روسيا، بينما لم تعارضه سوى خمس دول: بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسورية، بالإضافة إلى روسيا.
الخسارة الثالثة الكبيرة اقتصادية بالدرجة الأولى، لأن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضها الغرب على روسيا لن تسقط غدا بمجرّد ما تسكت المدافع، ولن تظهر نتائج آثارها المدمرة فورا، وإنما مع مرور الوقت، وهي كفيلةُ، لو استمرّت وقتا طويلا، وهذا مرجّح، أن تؤدي إلى التدهور الاقتصادي للبلاد التي تعتمد في صادراتها على الأسلحة والمحروقات والقمح، وتحتاج استيراد كل حاجياتها الأخرى من الخارج، وكلما اشتدّ طوق عزلتها المتزايدة ستسقط تدريجيا في الفقر والفوضى.
الخسارة الرابعة في هذه الحرب التي تكبدها بوتين وجيشه إعلامية بامتياز، بما أن كل حرب هي معركة من أجل الرأي العام، فأمام الآلة الإعلامية الغربية القوية ارتبطت صور هذه الحرب بصور المعاناة الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، وبجرائم الحرب المتعدّدة التي خلفها القصف الروسي العشوائي للمباني السكنية، وبالغضب الشعبي المتعاظم في دول الغرب، والمتضامن مع أوكرانيا بسبب أكبر موجة لجوء تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقريبا سينتقل هذه الغضب إلى بقية دول العالم، عندما تشتعل الاحتجاجات في الدول الفقيرة ضد ارتفاع الأسعار نتيجة تداعيات هذه الحرب التي كان وراءها قرار رجل واحد مصاب بجنون العظمة، هو فلاديمير بوتين.
وكيفما كانت تطوّرات هذه الحرب، فإن روسيا ستخرج منها منهكة ومعزولة عن بقية العالم، حتى لو انتصرت في المعركة الميدانية، لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى مزيد من العقوبات ضدها في كل المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية، وإلى عزلة سياسية ودبلوماسية وعسكرية كبيرة. أما إذا استمرت المقاومة الأوكرانية فستتحول أوكرانيا إلى مستنقع كبير، وتصبح المعركة حرب استنزاف طويلة الأمد لن تنتهي إلا بنهاية روسيا الحالية، وولادة روسيا جديدة. ويكفي العودة قليلا إلى الوراء، لنعرف أن نتيجة خسارة الإمبراطورية الروسية حربها ضد اليابان بداية القرن العشرين جاءت بالثورة البلشفية التي أنهت حكم القياصرة. وهزيمة أفغانستان نهاية ثمانينيات القرن الماضي عجّلت بتفكك الإمبراطورية السوفييتية. وخسارة بوتين حربه الحالية تعني نهاية حلمه بإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، وربما نهاية الرجل نفسه.
وقد علمتنا دروس التاريخين، الحديث والقديم، أن الحكام المستبدّين عندما يخسرون حروبهم يفقدون هيبتهم قبل أن يفقدوا سلطتهم، وينتهي الأمر بسقوط استبدادهم. لذلك لا أفهم لماذا يهلل بعضهم لانتصار بوتين، فأي انتصار له هو انتصار للمستبدّين في العالم، ويكفي أن نتيجة دخوله عام 2015 الحرب السورية التي ما زالت مستمرة كانت تقوية استبداد بشار الأسد الذي قتل وهجر نصف شعبه ودمر نصف بلاده، ليبقى هو في الحكم. وتدخله في أوكرانيا عام 2014 كان ردّا على ثورة الميدان الشعبية في كييف، التي أطاحت حكومة فاسدة موالية لروسيا. وطوال مسار حكمة منذ 20 عاما، أجهض الديمقراطية الروسية الفتية، وحوّلها إلى لعبة كراسي بينه وبين “الدمى الروسية” التي كان يتبادل معها الأدوار، وشجّع المستبدين في العالم لأنه أعطاهم النموذج والمثل في قمع شعوبهم والتمسّك بعروشهم. والنتيجة هي ما شهده العالم طوال العقدين الماضين من حروبٍ أهلية داخل هذه الدول المستبدّة أو في ما بينها، وجرأة مستبدّيها على قمع شعوبهم وهضم حقوقها. وقد كشف تقرير حديث عن الديمقراطية في العالم، صادر عن معهد “في ديم”، التابع لجامعة غوتبرغ في السويد، عن ارتفاع عدد الأنظمة الاستبدادية المغلقة من 25 إلى 30 بين عامي 2020 و2021، وأكثر أنواع الاستبداد شيوعا ما وصفه التقرير بـ “الاستبداد الانتخابي” الذي أسّس له نظام بوتين.
بوتين ليس نموذجا يحتذى، نظامه استبدادي يقوم على زواج مصلحة فاسدة بين الدكتاتورية والأوليغارشية، تغذّيه أيديولوجية يمينية قومية متعصّبة للعرق الروسي، وأي نجاح له سيجيّره المستبدّون لأنفسهم لتعزيز استبدادهم. أما خسارته فلن تؤدّي حتما إلى انتصار الديمقراطية، لكنها ستضع أوروبا والولايات المتحدة والغرب عموما أمام تحدّياتٍ أساسيةٍ تتطلب منها مراجعة مواقفهم المخاتلة والمراوغة في منافقة المستبدين من أمثال بوتين في العالم وما أكثرهم في منطقتنا العربية، والكفّ عن تبنّي خطابات مزدوجة تكيل بمكيالين، كلما تعلق الأمر بحقوق العرب والمسلمين، وترجّح المصالح الآنية على المبادئ الثابتة.
العربي الجديد
—————————-
أوكرانيا وتحالفات الشرق الأوسط/ مروان قبلان
لا يضيف المرء جديداً إذا زعم أنّ آثار أزمة أوكرانيا سوف تطاول العالم بأسره. وإضافة إلى أوروبا، سيكون الشرق الأوسط الأكثر تأثراً بها. عمق الآثار التي تتركها الأزمة هنا لا يوازيها إلّا السرعة التي تسري فيها، إذ ما زلنا في الأسبوع الثاني من الأزمة التي يتوقع أن تكون مديدة، ومع ذلك بدأت ترتسم ملامح تغييرات محتملة في تحالفات دول المنطقة الإقليمية والدولية، وهي وإن كانت تتبلور منذ فترة، إلّا أنّ أزمة أوكرانيا ساهمت في إبرازها. أولى ملامح هذه التغييرات تتمثّل في افتراق مصالح بعض دول الخليج العربية عن الولايات المتحدة واقترابها من روسيا والصين، فقد رفضت السعودية، وما زالت، طلبات أميركية متكرّرة لزيادة إنتاجها من النفط لكبح جماح الأسعار، وتعويض أيّ نقصٍ محتمل في الأسواق، في حال نقص المعروض الروسي، كبادرة عقابية من موسكو ضد الغرب، أو العكس. بدلاً من ذلك، أعربت الرياض عن تمسّكها باتفاقها أوبك + مع موسكو، الذي، وللمفارقة، توسّط فيه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لوقف حرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا في ذروة تفشّي وباء كورونا ربيع عام 2020. بالتوازي، امتنعت الإمارات، التي تحتل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن في الفترة 2022 – 2023، عن دعم مشروع قرار تقدّمت به واشنطن يوم 25 فبراير/ شباط الماضي لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل، صوّتت روسيا إلى جانب مشروع قرار قدّمته الإمارات، بعد ذلك بيومين، يصنّف الحوثيين تنظيماً إرهابياً، ويمدّد حظر السلاح ضدهم. فوق ذلك، ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أنّ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين في الأول من مارس/ آذار الجاري “عن تفهمه احتياجات روسيا الأمنية” فُهم دعماً لموقف موسكو في الأزمة.
وفي مقابل ابتعاد السعودية والإمارات عن المواقف الغربية، واقترابهما الحذر من الموقف الروسي، انتهزت إيران أزمة أوكرانيا لبناء جسور مع الغرب، مبتعدةً، في الوقت نفسه، عن “حليفتها” روسيا، إذ أعلنت استعدادها لتغطية أي نقصٍ محتمل في المعروض العالمي من النفط في حال رُفعت العقوبات المفروضة عليها، على خلفية برنامجها النووي، وأعربت فوق ذلك عن استعدادها لتزويد أوروبا بالغاز، بدلاً من الغاز الروسي الذي تسعى واشنطن إلى الحدّ من تدفقه لتجفيف موارد موسكو المالية، وهو موقفٌ أثار حفيظة هذه الأخيرة التي اعتبرته “طعنة في الظهر” وبادرةً تشجّع الغرب على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية. وقد ردّت روسيا بربط موافقتها على إحياء الاتفاق النووي الإيراني بإعفاء تعاملاتها مع إيران من العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها على خلفية غزوها أوكرانيا، وهو أمرٌ استنكرته أوساط إيرانية، واعتبرته محاولة لعرقلة إحياء الاتفاق. وقد أعاد ذلك إلى الأذهان اتهامات وزير الخارجية الإيراني السابق، جواد ظريف، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في شهادته الشهيرة المسرّبة، بأنّه حاول عرقلة التوصل إلى اتفاق 2015 النووي.
عدا عن ذلك، بدا لافتاً مقدار ابتعاد باكستان عن حليفتها السابقة، الولايات المتحدة، واقترابها من روسيا، إذ امتنعت إسلام أباد عن إدانة الغزو الروسي أوكرانيا، وعبّرت على لسان رئيس حكومتها، عمران خان، عن رفضها طلباً أوروبياً بهذا الخصوص جاء بعدما امتنعت، إلى جانب حليفتها الصين و33 دولة أخرى، عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس/ آذار الجاري لإدانة روسيا ومطالبتها بسحب قواتها من أوكرانيا. وكان لافتاً أنّ عمران خان التقى الرئيس بوتين في موسكو في اليوم نفسه الذي اجتاحت فيه القوات الروسية أوكرانيا، لمناقشة مشروع غاز “باكستان ستريم” الذي تزمع موسكو إنشاءه في باكستان. كما أشارت استراتيجية الأمن القومي الباكستانية لعام 2021، وهي أول وثيقة بهذا الشأن على الإطلاق، إلى الحاجة لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والدفاع والاستثمار.
قد يكون من المبكّر، حالياً، الحديث عن تغييرات عميقة في تحالفات دول المنطقة، فهذا يتوقف على وضع أميركا الداخلي، ونتيجة الحرب في أوكرانيا (خروج روسيا أقوى أو أضعف منها). مع ذلك، لم تعد خافية ميول هذه الدول لتنويع تحالفاتها ترقباً لتغييرات محتملة في الإقليم وعلى الصعيد الدولي.
العربي الجديد
————————–

نتائج عكسية للحرب/ أسامة الرشيدي
مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن مسؤولون روس أنهم يهدفون إلى تحقيق هدفين رئيسيين: نزع سلاح الجيش الأوكراني والقضاء على بنيته التحتية، حتى لا يشكل خطراً مستقبلياً، وضمان عدم توسّع حلف الناتو، وإلزام الحلف بالتخلي عن خطته لضم أي دولة مجاورة لروسيا. إلّا أنّ مجريات الحرب، حتى الآن، لا تبشر بخير بالنسبة للروس في ما يتعلق بتحقيق هذين الهدفين.
بالنسبة للهدف الأول، لا تستطيع روسيا ضمان تحقيقه، لأنّ الدول الغربية هبّت لتقديم مساعدات عسكرية كبيرة للقوات الأوكرانية لمساعدتها على التصدّي للغزو، وتعويض ما فقدته خلال المعارك، حتى أنّ دولاً كانت معروفة بالحياد، مثل ألمانيا والنمسا والسويد وسويسرا والنرويج، قدّمت مساعدات عسكرية لكييف، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وفرضت عقوبات على موسكو وسحبت استثماراتها من هناك. كما قدّمت الدول الغربية الأخرى مساعدات إنسانية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تقدّم مليارات أخرى بعد الحرب لإعادة بناء ما دمّر.
أما الهدف الثاني فهو الأكثر فشلاً، فقد أدّى الغزو الروسي إلى هرولة عدة دول لطلب الالتحاق بالكيانات الغربية، إذ تقدّمت أوكرانيا نفسها بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسط وعود من دول الاتحاد بتسريع الإجراءات. كما تقدّمت جورجيا بطلبٍ هي الأخرى، وهي دولة سبق أن عانت من الغضب الروسي عام 2008 عندما هزم الجيش الروسي القوات الجورجية، وأجبرها على التراجع عن منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وكذلك الأمر مع مولدافيا التي تكرر فيها سيناريو الجمهوريات الانفصالية بدعم من موسكو في منطقة ترانسنيستريا التي تنتشر فيها قوات روسية.
وبالنسبة لـ”الناتو” نفسه، والذي يهدف الغزو الروسي إلى منع توسّعه، فلا يبدو أنه سيتوقف عن ضم دول جديدة، مع تصاعد تأييد الرأي العام في فنلندا والسويد، المعروفتين بسياستهما المحايدة، للانضمام إلى الحلف، ففي فنلندا، جمعت عريضة تدعو إلى إجراء استفتاء على الانضمام للحلف 50 ألف توقيع في أقل من أسبوع، وأظهرت نتائج استطلاع أنّ نسبة المواطنين المؤيدين للانضمام تضاعفت من 28% إلى 53% خلال أسابيع فقط. وفي السويد، وصلت نسبة التأييد إلى 41%، وسط حديث محللين أنّ الحلف أرسل إشاراتٍ بأنّ دراسة انضمام البلدين يمكن أن تحصل سريعاً، في انتظار القرار السياسي من قيادتي الدولتين اللتين لم تأبها بالتحذير الروسي من رد عسكري على تلك الخطوة إن تمت.
وحتى الدول الأعضاء في حلف الناتو، مثل ألمانيا وبولندا، أدّى الغزو الروسي إلى اتجاهها نحو العسكرة، فوضعت الحكومة الألمانية خطة بقيمة مائة مليار يورو لتحديث قواتها المسلحة، كما عاد النقاش بين السياسيين عن ضرورة إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بعد تعليقها منذ عشر سنوات، لمواجهة التحدّيات الجديدة بعد صدمة الغزو الروسي.
وقد شهد حلف الناتو نفسه تضامناً وتنسيقاً كبيرين، لم يكونا حاضريْن في أزماتٍ سابقة، فقد حشد الحلف قوات تابعة له في عدة دول على الحدود مع روسيا، مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق، وقرّر لأول مرة تعبئة قوة الرد التابعة له، ونشرها في أوروبا الشرقية، رداً على الغزو الروسي.
وشهدت بولندا التي تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين تزايداً في عدد الرجال والنساء الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش، إذ تقدّم 2200 شخص في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مقارنة مع متوسّط عدد طلبات شهري يبلغ 400 فقط. كما زاد الإقبال على التطوع في ما يسمى “جيش الدفاع الإقليمي” الذي يمنح تدريباتٍ عسكرية للمنضمين إليه مرة واحدة شهرياً.
وحتى في الشرق الأوسط، بدأ النقاش يتصاعد حول ضرورة استغلال انشغال روسيا بالمعركة، لتحريك الملفات العالقة في سورية وليبيا، إذ تدعم موسكو نظام بشار الأسد وتقاتل لصالح قوات خليفة حفتر شرقي ليبيا عبر مرتزقة شركة “فاغنر”، ولذلك يمكن أن تكون للحرب على أوكرانيا نتائج سلبية بالنسبة للوجود الروسي في هذين البلدين.
كما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة وعزلة دولية متزايدة، استفاضت وسائل الإعلام في الحديث عن تفاصيلها وتحليل تأثيرها. وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أنّ روسيا بصدد التراجع عن غزوها، بعدما أكد بوتين للرئيس الفرنسي، ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، أنّ “نزع سلاح أوكرانيا إذا لم يتم سياسياً فإنّه سيتم عسكرياً”. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ لدى بلاده قائمة بأسلحة محدّدة “لا يمكن نشرها على الأراضي الأوكرانية”. وهو ما يشير إلى أنّ الأزمة مرشّحة للتصاعد، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ روسيا لا يزال بإمكانها تحقيق نصر عسكري واضح على أوكرانيا، حتى وإن تأخر بعض الشيء، لكنّ الأهم أن ينعكس هذا النصر العسكري على مائدة المفاوضات لصالح تحقيق الأهداف الروسية.
العربي الجديد
————————-
حظر النفط الروسي … أوروبا المأزومة والحائرة/ مصطفى عبد السلام
أوروبا تقدم رجلاً وتؤخر أخرى في الانضمام لتحالف غربي واسع يفرض عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي سواء كان نفطا أم غازا، والانضمام للقرار الأميركي بشأن الحظر الذي تم اتخاذه مساء أمس الثلاثاء.
فبضاعتها من العقوبات الجديدة والقائمة ستُرد إليها وبقوة في شكل خسائر مالية فادحة، وتكاليف إضافية، وقفزات في أسعار الأغذية والبنزين والسولار والغاز والمواد الأولية والسلع الخام واشباه الموصلات وغيرها.
والقارة العجوز تدرك ذلك جيدا، ولذا فإن معظم دولها بما فيها القوية اقتصاديا مثل ألمانيا تعارض القرار الأميركي بفرض عقوبات نفطية على روسيا.
صحيح أن العقوبات الغربية المتواصلة منذ غزو أوكرانيا ضربت بقوة مفاصل الاقتصاد الروسي، وأثرت سلباً على قطاعه المالي والمصرفي والتجاري، وشلت المعاملات الخارجية للدولة، وأدت إلى حدوث قفزات في كلفة الواردات، وتهاوٍ في قيمة العملة المحلية الروبل مقابل الدولار، وحدوث اضطرابات شديدة في أسواق المال والبورصات، وارتباك في الأسواق الداخلية وحركة التجارة، وقفزات في الأسعار بما فيها السلع الغذائية، وعرقلت جزءا من الصادرات الروسية، وقللت الإيرادات العامة، لكن في المقابل فإن الغرب، اقتصاده وأسواقه شركاته ومواطنيه، تضرر أيضا من تلك العقوبات الجماعية على موسكو والتي تزيد رقعتها يوماً بعد يوم.
أوروبا تدرك جيداً أنّ فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي قد يدفع روسيا إلى اتخاذ خطوات عقابية دفاعية منها على سبيل المثال حظر تصدير الغاز والنفط والمواد الأولية إلى أوروبا، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي أعلن أن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا.
وهذا يعني ببساطة كارثة للقارة العجوز، وحدوث قفزات قياسية في أسعار الغاز والوقود والسلع بها، وتعرض المواطن الأوروبي لضغوط تضخمية وحياتية شديدة ممثلة في حدوث قفزة في كلفة الإنتاج والمعيشة والسلع الغذائية وفواتير الكهرباء والتدفئة وأسعار البنزين والسولار وغيرها.
أوروبا تتحدث يوميا عن أمكانية الاستغناء عن الغاز الروسي، وهذا كلام للاستهلاك الإعلامي ليس إلّا، لأنها تدرك صعوبة إن لم يكن استحالة الاستغناء قريباً عن ذلك الغاز المتدفق حتى الآن والذي يمثل نحو 40% من احتياجاتها، خاصة في ظل شتاء قارس وقفزات في أسعار الغاز عالميا قبل الحرب، وعدم وجود بدائل سريعة لاستيراد الغاز سواء من قطر أو الجزائر أو الولايات المتحدة أو مناشئ أخرى. كما لا تستطع الاستغناء عن النفط الروسي.
كما تدرك القارة العجوز أن إقدام روسيا على وقف تدفق إمدادات الغاز سيصيب المصانع الأوروبية بالشلل التام، وقد رأينا قبل أيام كيف تعرض قطاع صناعة السيارات الألماني لحالة شلل، وتوقف بعض المصانع والشركات الألمانية الكبرى عن تصدير السيارات، وحدوث تراجع في إنتاج مصانع أوروبية كبرى.
وذلك لأن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى حدوث نقص شديد في أشباه الموصلات وقطع الغيار وأحزمة الكابلات من روسيا وأوكرانيا، كما أدت إلى حدوث نقص في المواد الخام المخصصة للتصنيع، مثل غاز النيون والبلاديوم والنيكل، حيث تعتبر أوكرانيا أحد أكبر موردي النيون، وهذا الشلل قد يمتد لاحقا إلى معظم مراكز الإنتاج في أوروبا.
أوروبا ستتضرر بشدة من الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن القرار الأميركي الخاص بحظر النفط والغاز الروسي، كما ستتضرر من العقوبات التي تفرضها مع الولايات المتحدة والتحالف الغربي على روسيا.
وقد تمتد التأثيرات إلى قطاع الحبوب، حيث إن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري الحبوب والقمح على مستوى العالم، وفي كل الأحوال فإن القارة العجوز على موعد مع أزمات جديدة تنهك اقتصادها كما أنهكته جائحة كورونا في العامين الأخيرين.
زحام شديد على محطات الوقود في مصر
وأوروبا والولايات المتحدة تدركان معا أن الاقتصاد الروسي ليس من ورق، فلديه مقومات وأصول ضخمة، ويملك أوراق ضغط وأدوات قوية، وروسيا لا تزال سوقا واعدا للشركات الغربية، ولذا فإن العقوبات الغربية لن تحوله إلى اقتصاد هش كما يحلو لوسائل الإعلام الغربية أن تردد.
صحيح أنها ستؤثر عليه بشدة خاصة على المستوى الخارجي مع التحفظ على نصف الاحتياطي الروسي من النقد الأجنبي، وحرمان بنوك روسية كبرى من نظام سويفت، واعتماد السوق الروسي على مواد خام وسلع وسيطة قادمة من أوروبا. وصحيح أنها ستضعفه كما حدث في سنوات ماضية.
لكن تكرار تجربة التسعينيات، وعمل الغرب على انهيار روسيا من بوابة الاقتصاد كما حدث مع الاتحاد السوفييتي، أظن أنه مسألة مستبعدة في القريب العاجل والمستقبل المنظور، خاصة مع قيام حكومة فلاديمير بوتين بمحاولة تحصين الاقتصاد من الأزمات الخارجية في السنوات الأخيرة.
العربي الجديد
—————————–

سيرغي لافروف… نسخة أكثر تشدداً من “السيد لا”/ بشير البكر
يعود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للواجهة مرة أخرى. لا أحد يشغل الإعلام العالمي اليوم أكثر منه.
ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو صاحب مشروع غزو أوكرانيا، فإن وزير خارجيته هو الذي يؤدي دور “المايسترو”، وفق ما سار عليه منهج تقسيم العمل بين الرئيس والوزير، منذ تسلّم لافروف مهامه على رأس أهم الوزارات في تاريخ هذا البلد، في 9 مارس/ آذار عام 2004، ولم يبرحه حتى اليوم.
وعايش بذلك عدة محطات مهمة، وواجه تحديات دخلت فيها روسيا في مواجهات دبلوماسية كبيرة، ومن بينها أحداث جورجيا في صيف عام 2008، وتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا عام 2011 ضد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، والتدخل العسكري الروسي في سورية في سبتمبر/أيلول عام 2015.
ليس هناك دبلوماسي أميركي أو أوروبي مارس هذه المهنة طوال العقدين الماضيين، إلا ولديه قصة أو أكثر مع لافروف. وكان قد بدأ حياته الدبلوماسية في 1972 ملحقاً دبلوماسياً في السفارة السوفييتية في سريلانكا، بعد أن درس لغة أهل تلك البلاد “السنهالية” في معهد العلاقات الدولية في موسكو، وهو ثاني اختصاص له.
ودرس لافروف الفيزياء في البداية، وكان لامعاً في هذا المجال، حسب معارفه، لكنه تحول إلى اللغات الإنكليزية، الفرنسية، والسريلانكية، التي رفض على الدوام أن يقدم سبب دراسته لها.
لكنه كان يعرف جيداً أن اللغات الأخرى ستأخذه للعمل في السلك الدبلوماسي من عام 1976، بدءاً من وزارة الخارجية، ومن ثم مندوب روسيا في الأمم المتحدة في 1994، حيث برز هناك وذاع صيته، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر والحرب على أفغانستان في 2001، ومن ثم غزو العراق عام 2003.
3 أمثلة أمام لافروف
وبعدها استدعاه بوتين ليجلس جانبه، ويدير وزارة الخارجية التي تحتل مكانة مهمة في السياسة الروسية على الدوام. وحين تسلّم مهامه، كان أمامه ثلاثة أمثلة لوزراء سبقوه إلى هذا المنصب.
الأول هو القومي ألكسندر غورتشاكوف، الأمير الذي شغل منصب وزير خارجية روسيا بعد هزيمتها أمام الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا في حرب القرم منتصف القرن التاسع عشر، وتوقيع معاهدة باريس في 1856.
والمثال الثاني هو أندريه غروميكو، وزير خارجية الاتحاد السوفييتي بين 1957 و1985، والملقب بـ”السيد نيت” (لا) لكثرة استخدامه حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي. والثالث هو يفغيني بريماكوف، الذي شغل المنصب بين 1996 و1998، وهو من أب أوكراني، ولد في جورجيا.
واستشهد لافروف بفخر، عدة مرات، بغورتشاكوف، الذي نجح في “استعادة النفوذ الروسي في أوروبا، بعد الهزيمة في حرب القرم، وقام بذلك دون تحريك بندقية، بل فعل ذلك حصراً من خلال الدبلوماسية”.
ونفض لافروف الغبار عن كتب التاريخ القيصرية، وأعاد إحياء غورتشاكوف كنموذج لدبلوماسية روسية جديدة. وكتب مقالاً طويلاً يشيد بمناورات غورتشاكوف الذكية في السياسة الواقعية. وحتى إنه نصب له تمثالاً نصفياً في وزارة الخارجية، التي توصف بأنها ناطحة سحاب ستالينية مليئة بالآلاف من البيروقراطيين العاطلين من العمل، الذين بالكاد كانوا يتقاضون رواتبهم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
وحين تسلّم لافروف الخارجية، علّق الوزير الأسبق، الذي كان أول من تولى المنصب بعد نهاية الحقبة السوفييتية، أندريه كوزيريف، قائلاً: “إنه خيار معقد على الأقل”. وأشار إلى الأحاديث التي صدرت في السنوات الأخيرة عن العديد من حلفاء بوتين، الذين أشادوا بوزير خارجية جوزيف ستالين، فياتشيسلاف مولوتوف، الذي تُنسب إليه كتابة المعاهدة السرية مع النازيين لتقسيم أوروبا الشرقية. وقال: “من الأفضل التظاهر بأنك تتبع غورتشاكوف، بدلاً من اتباع مولوتوف”.
نقطة التحول في السياسة الخارجية لروسيا
يمثل تعيين بريماكوف وزيراً للخارجية في 1996 نقطة تحول في السياسة الخارجية الروسية، التي كانت تسعى للتوافق مع الغرب. ووفقاً للافروف، فقد نفذ بريماكوف خروجاً جذرياً عن هذا المسار. وقال: “لقد تركت روسيا طريق شركائنا الغربيين… وشرعت في مسار خاص بها”.
ظلت روسيا على مسارها منذ ذلك الحين، وظهر ذلك بوضوح في قرار بريماكوف إلغاء زيارته لواشنطن في الجو، وأمر طياره بالعودة إلى موسكو، احتجاجاً على قصف حلف شمال الأطلسي لصربيا في مارس 1999.
ومنذ ذلك الحين صار يجري الحديث عن “عقيدة بريماكوف”، التي تقوم على أولوية روسيا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، والسعي لتحقيق تكامل أوثق بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة مع روسيا في الصدارة، ومعارضة توسيع “الناتو”، وبذل الجهود لإضعاف المؤسسات عبر الأطلسي والنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والشراكة مع الصين. وهذا ما يشكل ركائز السياسة الخارجية الروسية اليوم.
وبالنسبة إلى الدبلوماسيين الأميركيين، الذين دخلوا بمواجهات معه، فإن لافروف نوع من التجديد السوفييتي المتطور ببزة إيطالية، وهو الدكتور “نيت” المحدّث. ووصفه ديفيد كرامر، المساعد السابق لوزيرة الخارجية في إدارة جورج بوش الابن، كونداليزا رايس بأنه “نسخة حديثة من السيد “لا”. غروميكو في العصر الحديث. مثل الروس بشكل عام، يريد الاحترام، لذلك يبحثون عن طرق لممارسة حق النقض”.
وحين سأل صحافيون لافروف ما الذي تغير في سياسة موسكو الخارجية منذ تسلم بوتين السلطة في عام 2000، لم يتطرق إلى هذا الأمر، بل ألقى محاضرة حادة حول كيف تمكن رئيس الكرملين من جعل روسيا عظيمة مرة أخرى، بعد الإهانات التي تلقتها في تسعينيات القرن الماضي. والأهم من ذلك، كيف يمكن روسيا عظيمة مرة أخرى، أن تتمتع بسياسة خارجية “حازمة”.
وتشعر روسيا بأنها أكثر حزماً. ليست عدوانية، لكنها حازمة. وقال لافروف: “لقد خرجنا من الموقف، حيث وجدنا أنفسنا في أوائل التسعينيات عندما اختفى الاتحاد السوفييتي، وأصبح الاتحاد الروسي على ما هو عليه كما تعلمون”. وهو يعني أنه أصبح بلا حدود، ودون ميزانية ولا أموال ومشاكل ضخمة، بدءاً بنقص الغذاء وما إلى ذلك.
واعتبر لافروف أن روسيا “دولة مختلفة للغاية الآن. وبالطبع، يمكننا الآن أن نولي المزيد من الاهتمام لرعاية مصالحنا المشروعة في المناطق التي كنا غائبين عنها لبعض الوقت، بعد زوال الاتحاد السوفييتي”. والمناطق التي ذكرها، هي أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. بمعنى آخر، وإلى حد كبير، بقية العالم. كانت الرسالة واضحة لأولئك الذين يتذكرون كيف كانت تبدو السياسة الخارجية الحازمة للعصر السوفييتي.
وُلد سيرغي فيكتوروفيتش لافروف في 21 مارس 1950، على مشارف نهاية الحقبة الستالينية في 1953، وقبل سنوات قليلة من بدء غروميكو مسيرته الطويلة في مهمة قول “لا”. وهو وُلد في موسكو لأب أرمني وأم روسية من جورجيا.
شخصية لافروف تهيمن على مجلس الأمن
وخلال مهمته في الأمم المتحدة، هيمنت شخصية لافروف في كثير من الأحيان على مجلس الأمن بملاحظاته الحادة، وروح الدعابة اللاذعة، وبنيته المهيبة جسدياً. وكان معروفاً بحماسته للتدخين.
ويتذكر أحد السفراء الغربيين، الذين خدموا في مجلس الأمن، عندما حظرت الأمم المتحدة التدخين في عام 2003، احتجاج لافروف على هذا الأمر، رافضاً التوقف عن التدخين، بينما اشتكى بشدة من أن الأمين العام آنذاك كوفي عنان “لا يمتلك هذا المبنى”. ويروي مسؤول أميركي كبير سابق، قضى عدة ساعات على الطاولة أمامه، أنه “كان يدخن مثل المدخنة… إنه يذكرك بالشكل الذي كان يبدو عليه الدبلوماسيون في القرن التاسع عشر”.
كان لافروف موهوباً في إثارة حنق كونداليزا رايس، التي عملت مساعدة خاصة للرئيس جورج بوش الأب للشؤون السوفييتية، قبل أن تعمل مع نجله الرئيس جورج بوش الابن مسؤولة مكتب الأمن القومي ووزيرة خارجية.
وكتبت رايس، في مذكراتها التي عنونتها “أسمى مراتب الشرف”، أنها طورت، في البداية، مع لافروف “علاقة جيدة، رسمية إلى حد ما وأحياناً مثيرة للجدل. لقد كان، مثلي، مناظراً طبيعياً لا يمانع في القتال اللفظي”.
ومع ذلك، في وقت لاحق من ولايتها، أصبحت تنظر إليه بشكل متزايد على أنه متنمر، ليس فقط بسبب إصرار روسيا على البروز مجدداً على المسرح العالمي. وجاءت الضربة الأقوى في أثناء الغزو الروسي لجورجيا في صيف 2008.
تقول رايس، في مذكراتها، إنها اتصلت به هاتفياً بينما كان يقضي إجازة، فقابلها بتهكم أغضبها. وفي المكالمة الثانية، كان لديه ثلاثة مطالب. الأول والثاني حول وقف الأعمال العدائية، فيما نقلت عن لافروف قوله إن “المطلب الآخر بيننا فقط. (رئيس جورجيا) ميخائيل ساكاشفيلي يجب أن يرحل”.
وتقول إنها ردت عليه بأنه ليس في وسع وزيرة الخارجية الأميركية الاتفاق مع وزير الخارجية الروسي على إطاحة رئيس دولة منتخب ديمقراطياً، و”الشرط الثالث أصبح علنياً، لأنني سأتصل، وأنشر الخبر بأن روسيا تطالب بإطاحة الرئيس الجورجي”. ولم ينجح لافروف في ثنيها، وإصراره على أن “الأمر كان بيننا”.
ساركوزي وصف لافروف بالكاذب
ولم تكن رايس الوحيدة التي أغضبها لافروف خلال الأزمة. بل كذلك الرئيس الفرنسي في ذلك الحين نيكولا ساركوزي، الذي قام بجولة مكوكية لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار في أوسيتيا الجنوبية.
ووفقاً لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الفرنسية، نُشرت في وقت لاحق على موقع “ويكيليكس”، فإن “ساركوزي أمسك لافروف من طيّة صدر السترة، ووصفه بالكاذب”، وأن ساركوزي حذّر روسيا من أن موقعها “كقوة كبرى قد تضرر بشكل خطير بسبب رفضها احترام التزاماتها”. ولكن ما كان يهم روسيا في حينه، منع انضمام جورجيا إلى “الناتو”، ورحيل سكاشفيلي، وهذا ما حصل.
بحلول ربيع 2011، عندما اندلعت ثورات “الربيع العربي”، وكان معمر القذافي يهدد بسحق مدينة بنغازي، ذهبت روسيا إلى حد الامتناع عن التصويت، بدلاً من “الفيتو”، على قرار توسطت فيه الولايات المتحدة في مجلس الأمن، يأذن بفرض منطقة حظر طيران لحماية المدنيين الليبيين. ومنذ ذلك الحين، كان لافروف يصرّ على أن روسيا لم تمنح الإذن بالتدخل العسكري الغربي لإطاحة القذافي، الذي أعقب ذلك.
بعد بضعة أشهر، جعل لافروف من سورية قضيته. وخاض مواجهات مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، ولم يهدأ باله حتى حلّ مكانها جون كيري، الذي أشادت به وسائل الإعلام الروسية وأنه “رجل يمكن روسيا التعامل معه”. وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما، أليكسي بوشكوف، إن كيري ولافروف كانا في الواقع صديقين “براغماتيين محترفين” ويتعاونان بشكل رائع.
وفشل الأميركيون مرة أخرى في تغيير موقفه من سورية. وكان على الدوام يشهر في وجه وسائل الإعلام رأي غورتشاكوف، أن “التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية غير مقبول… من غير المقبول استخدام القوة في العلاقات الدولية، وخاصة من قبل الدول التي تعتبر نفسها قادة الحضارة”. وهذا ما لم يطبقه لافروف في ليبيا وسورية وجورجيا، وترك للقوة أن تقرر، وتصبح اللغة الوحيدة، وهذا ما يحصل اليوم في أوكرانيا.
لافروف يجسد موقف الكرملين المتحدي
وفي سن الـ71، أصبح لافروف أكثر بكثير من مجرد لسان حال بوتين. وباتت مسيرته الدبلوماسية تمتد على 50 سنة. عاصر الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي. ومنذ عقدين يدير علاقة موسكو بالغرب. وفي خضمّ الغزو الروسي لأوكرانيا، يجسد لافروف موقف الكرملين المتحدي، باعتباره أكبر دبلوماسي في البلاد.
أما الوصف الذي أطلقته عليه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، منذ أيام، بأنه “كلب هجوم بوتين المخلص”، فيأتي لأنه نذير الرئيس الروسي، ولا سيما حين هدد بأن الحرب العالمية الثالثة ستكون “نووية ومدمرة”، وفي ذلك رسالة صريحة من بوتين لحلف شمال الأطلسي والغرب.
ولكن على الرغم من أن لافروف مكلف إيصال رسائل رئيسه إلى العالم بأسلوب وحشي، إلا أنه أكثر بكثير من مجرد لسان حال بوتين. وهو يراقب علاقات بلاده مع الغرب، وقد انتقلت من شبه ودية إلى شفا حرب نووية. ولكن بالنسبة إلى الكثيرين، فإن قدرة لافروف اللامتناهية على تحدي الأميركيين هي بالضبط النقطة المهمة.
قد يكون لروسيا عدد قليل من الأصدقاء الحقيقيين ما بعد الاتحاد السوفييتي. فقد ولّت منذ فترة طويلة الإعانات السخية التي يقدمها النظام الروسي، ومبيعات الأسلحة المحسّنة، لكن هناك العديد من القوى الناشئة التي ابتهجت لاستعداد لافروف لتحدي القوة العظمى. مهمته الأساسية ليست تقريع أميركا، بل الترويج لروسيا. إنه “السيد نيت” في نظر الأميركيين. لكنه في الحقيقة ليس غروميكو ولا بريماكوف. صلابة لافروف تأتي من موقف “قومي” للغاية. إنه يعتقد أن تسعينيات القرن كانت إذلالاً لروسيا، وطموحه استعادة صورة روسيا وسياستها الخارجية، وهذه هي نقطة اللقاء مع بوتين.
————————-
تركيا وخيار “عدم الانحياز”/ عمر كوش
انتظر الساسة الأتراك عدة أيام، لكي يصفوا ما يجري في أوكرانيا أنه “حالة حرب”، بعد أن كانوا يصفون الغزو الروسي، كما تصفه روسيا، أنه “عملية عسكرية روسية”، كي يتجنّبوا تبعات التوصيف، وخصوصا المتعلقة بتطبيق اتفاقية مونترو، التي تتيح لتركيا إغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن والبوارج العسكرية في أوقات الحرب أو في حال تعرّض تركيا للخطر.
وسبق لأوكرانيا أن طلبت من تركيا إغلاق مضائقها في وجه السفن الحربية الروسية، لكن الأخيرة اكتفت بالتشديد على “الدور الفعال لاتفاقية مونترو في الحفاظ على السلام الإقليمي”، ووجدت مخرجاً لحرجها في عدم توصيفها ما يجري حالة حرب، ولكن بعد تغير توصيفها من “عملية عسكرية” إلى “هجوم غير مقبول” إلى “حالة حرب” بين دولتين من دول حوض البحر الأسود، يشكل فيها هذا البحر إحدى جبهات القتال، فضلاً عن انخراط حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيها بشكل غير مباشر، فإن ذلك كله دفع وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، إلى القول إن بلاده “ستطبق اتفاقية مونترو بشكل شفاف”، وإنها “أخطرت جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية للمرور عبر مضائقنا”.
لم تكن تركيا في حاجة إلى آراء حقوقيين وخبراء عسكريين، من أجل توصيف ما يجري بين روسيا وأوكرانيا حالة حرب، وذلك كي تبرّر تطبيق اتفاقية مونترو، لكن هذه الخطوة تعكس تغيراً رمزياً محدوداً في الخطاب السياسي التركي، على الرغم من أنها لا تخرج عن سياق عدم اتخاذ الساسة الأتراك خطواتٍ أبعد من اللازم، وتُفضي إلى إغضاب روسيا وتعكير مجرى العلاقات معها.
والواقع أن تركيا باتت في موقفٍ لا تُحسد عليه بعد شن روسيا حربا على أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط الجاري، وذلك بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تربطها مع كل من روسيا وأوكرانيا. لذلك حاول ساستها اتخاذ موقف وسطية من الحرب، من خلال عدم إظهارهم مواقف تميل إلى أحد الطرفين، الروسي والأوكراني، وهو ما بدا صعباً لأن الغزو الروسي يجسّد مواجهة بين روسيا من جهة، وكل من أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية ومعها حلف الناتو من جهة أخرى، الأمر الذي شكّل اختباراً لتوجهات السياسة الخارجية التركية ولعلاقاتها الدولية، بوصفها عضواً في حلف الناتو الداعم لأوكرانيا، وتربطها علاقاتٌ عسكريةٌ واقتصادية مع أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ترتبط بعلاقات متعدّدة المستويات مع روسيا، فضلاً عن التنسيق معها، والتنافس كذلك، في ملفاتٍ إقليمية عديدة، الأمر الذي يُثقل موقفها بحسابات معقدة.
وقد بذلت تركيا، منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مساعي دبلوماسية عديدة، لتجنّب اندلاع الحرب، حيث اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي الإطار المناسب لحلحلة الأزمة، وليس حلف الناتو، ثم عرض وساطته بين الطرفين، لكنها لم تلق آذاناً روسية صاغية، نظراً إلى اعتبارات كثيرة، منها أن روسيا لا تعد تركيا وسيطاً حيادياً في أزمتها مع أوكرانيا، وترتبط معها بعلاقات قوية في مجالات متعدّدة، لكن الأهم هو التأكيد التركي الدائم على دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية، وإصرارها على عدم الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمها بعض أنشطة تتار القرم. ومع ذلك، استمرّ الساسة الأتراك في محاولتهم الإمساك بالعصا من المنتصف، عبر اتخاذ مواقف وسطية، والوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، فمن جهة أولى أكّدوا على وحدة الأراضي الأوكرانية وسلامتها، ووجهوا تحذيرات إلى روسيا من مغبّة غزوها، فيما انتقدوا، من جهة ثانية، مساعي حلف الناتو لضم أوكرانيا إلى عضويته، واعتبروا أن دول الحلف، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، لم تضع المخاوف الأمنية الروسية في الحسبان.
ولم تتغير المواقف التركية الوسطية كثيراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ عدّته القيادة التركية غير مقبول، ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مع تأكيدها مواصلة دعمها وحدة أوكرانيا وسيادتها، ووجهت سهام نقدها إلى حلف الناتو، لأنه لم يتخذ خطواتٍ أشد حزماً حيال تطوّرات الأزمة قبل الغزو، لكن الأمر لم يصل إلى حد الانخراط في تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا، مثلما فعلت دول حلف الناتو والولايات المتحدة وسواها، وذلك حرصاً على علاقاتها مع روسيا.
ولا يبتعد موقف أنقرة من الغزو الروسي لأوكرانيا من حسابات المصالح مع كلا الطرفين، إذ تربطها مع أوكرانيا علاقاتٌ اقتصاديةٌ وسياسيةٌ وأمنيةٌ هامة، حيث تعدّ أوكرانيا من كبار شركائها التجاريين، خصوصا بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.42 مليارات دولار في العام الماضي، إلى جانب أن أكثر من مليوني سائح أوكراني زاروا تركيا في العام الماضي، كما بدأ البلدان بتنفيذ مشروع لتطوير محركات الطائرات، والتعاون في مجال صناعة الأسلحة عالية الدقة، وتبادل الخبرات للجمع بين القدرات الدفاعية لكلا البلدين، وإنتاج أسلحة حديثة جديدة لجيشيهما. كما باعت تركيا طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا، واستخدمتها الأخيرة ضد القوات الروسية.
في المقابل، شهدت العلاقات التركية الروسية تنامياً مضطرداً في السنوات القليلة الماضية، انعكس في انتقالها إلى مستويات جديدة من التعاون والتنسيق بينهما، حيث توسّعت مجالات الشراكة والتعاون بينهما على المستوى الاقتصادي، وخصوصا في مجال الطاقة، عبر توقيع اتفاقيةٍ ستبني روسيا بموجبها مفاعلاً نووياً في تركيا، فيما توصلت الدولتان، على المستوى السياسي، إلى بناء تفاهمات وتوافقات في ملفات إقليمية عديدة، على الرغم من التنافس بينهما، بدءاً من سورية ومروراً في ليبيا ووصولاً إلى ناغورني كره باخ. أما في المجال العسكري فتوجها لشراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400 المثيرة للجدل.
ولا يخرج الموقف التركي من الغزو الروسي لأوكرانيا عن الخطوط العامة للسياسة التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، والتي تجد متحقّقها في تحالفات مرنة، يجسّدها نزوع تركيا نحو الاستقلالية، والموازنة بين توجهاتها نحو الشرق أو الغرب، مع تقليص دورها الوظيفي التابع للغرب، من خلال بناء تفاهمات وتوافقات، بدلاً من الاعتماد على حليفٍ مُهيمن، بما يفضي إلى الاستفادة من حليفها الغربي الأطلسي، ومن الشراكة مع روسيا والصين بمنافعها الدفاعية والاقتصادية، من دون التخلي عن أحدهما. لذلك أعلن الرئيس أردوغان أنه لن يتخلى “عن روسيا أو عن أوكرانيا”، بمعنى أن بلاده لن تنحاز إلى روسيا ولا إلى أوكرانيا، لأن الانحياز إلى طرف على حساب الآخر سيكلفها ثمناً باهظاً، لكن هذا الموقف قد يترتّب عليه تبعات كثيرة، خصوصا وأن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر معادلات وحسابات واصطفافات عديدة في أوروبا والعالم، وربما يترك آثاراً وتبعات كارثية على مختلف المستويات.
العربي الجديد
————————
لماذا يلوح بوتين بالجهاديين في أوكرانيا؟/ عبدالناصر العايد
تثير الريبة تلك الاتهامات التي تكيلها روسيا للدول الغربية بإرسال “جهاديين” إلى أوكرانيا. وكسوريّ اختبر وعانى هذا النوع من الدعاية، سرعان ما ارتسم في مخيلتي سيناريو قاتماً لما يمكن أن يحدث. فبوتين والقوى التي تلوذ به، إذا ما تحدثت عن الإرهاب والجهاديين، فإن هذا يعني أنها ستستخدمهم.
بالطريقة ذاتها التي تدعو للاستغراب، وما أن انطلقت الاحتجاجات في سوريا العام 2011، قال بشار الأسد إن من يتظاهرون ضده هم من الجهاديين، وأن هدفهم إقامة إمارات سلفية. مع ذلك، أطلق سراح معتقلين متطرفين من سجن صيدنايا الشهير، وتغاضت قواته عن البؤر العسكرية التي انشأوها هنا وهناك، وانسحب من حقول النفط لصالحها، وترك كتائبهم تتنامى بسرعة مدهشة، من دون أن تعترض قواته طريقها، بينما كان “الجيش الحر” والمدن والبلدات التي تحتضنه تسحق تحت قصف مروع.
في الخطوة التالية، وعندما وصل الثوار إلى مشارف قصر رئيس النظام السوري في دمشق، العام 2014، أطلق أسلحته الكيماوية، وقتل المئات، واتهم الجهاديين بأنهم هم من استخدموها. كانت الولايات المتحدة والدول الغربية تعرف الحقيقة الكاملة، وسبق للرئيس أوباما أن حذر من استخدام السلاح الكيماوي، وقال إنه الخط الأحمر الذي يعني تجاوزه تدخلاً أميركياً مباشراً ضد الأسد، وبدأ الحشد الغربي عسكرياً. لكن الأسد، وعبر موسكو، أخبر القوى الغربية بأنه يمتلك أكثر من 1300 طن من الأسلحة الكيماوية الفتاكة، وأنها مخزنة في طول البلاد وعرضها، بما فيها المناطق التي ينشط فيها الجهاديون، وكان المعنى المباشر لذلك هو: إذا ما ضربتموني، سأمنح تلك الأسلحة للمتطرفين المتعطشين لكل دفقة من السارين.
ورغم معارضة الرئيس الفرنسي حينها، فرانسوا هولاند، تراجع الرئيس الأميركي عن خطوطه الحمراء، وخضع للابتزاز والتهديد، وأعلن الصفح عن الجريمة فيما لو سلّم المجرم سلاحه. وعقدت اتفاقية مع الوكالة الدولية لحظر السلاح الكيماوي، حصل الأسد بموجبها على تفويض مدته سنة لتسليم تلك الذخائر المحرّمة دولياً وتدميرها، واستخدم ذلك التفويض لتدمير المدن السورية واستعادة السيطرة عليها. وبعدما وقف الأسد على قدميه مجدداً بمساعدة موسكو وطهران، استخدم السلاح الكيماوي مجدداً ضد المدنيين العزل في العام 2017، وأطلق الرئيس ترامب بضعة صواريخ “توما هوك” على قاعدة الشعيرات التي انطلق منها الهجوم، وانتهى الأمر. لكن تقارير وكالة حظر السلاح الكيماوي الدولية ما زالت تؤكد بأن الأسد يحتفظ بأسلحة كيماوية، كما تفيد تقارير إعلامية بأنه استأنف عمليات التصنيع بمساعدة إيرانية.
بالعودة إلى الساحة الأوكرانية، يخيل إلي، كعسكري سابق، أن ما يقلق بوتين ليس الصراع النووي الذي يبدو بعيد الاحتمال نوعاً ما، إنما حرب المقاومة الشعبية التي قد تنشأ في أوكرانيا بُعيد احتلالها. فشبح أفغانستان ما زال يخيم عليه، خصوصاً أن القوى الغربية سكبت مئات صواريخ ستينغر وجافلين في الميدان، وهي أسلحة حرب العصابات الأكثر فعالية وفتكاً.
تمثل الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف، مثل ستينغر الأميركية وإيغلا الروسيّة، تهديداً خطيراً للأمن والسِّلم في العالم. فعلاوة على قدرتها على إسقاط الطائرات الحربية عند تحليقها على ارتفاع منخفض أو متوسط، أو عند تقربها للهبوط، فإنها قادرة على إسقاط أي طائرة مدنية، مع استحالة معرفة المتسبب في الهجوم. لذلك يسري بروتوكول غير معلن بين القوى العظمى، يمنع تسرب تلك الأسلحة للجهات غير الحكومية، تحت التهديد بالردّ بالمثل. وقد عانى الثوار في سوريا كثيراً بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تلك الأسلحة، ودمرت حوامات نظام الأسد مدناً كاملة بالبراميل المتفجرة بسبب التزام الدول الداعمة للثوار بهذه الاتفاقية غير المعلنة. بل إن واشنطن امتنعت عن تقديمها لأكثر حلفائها موثوقية، أي “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تعاني بشكل يومي، هجمات الطائرات بلا طيار التركية، من دون أن تتمكن من الدفاع عن نفسها.
ما أتصوره هو أن بوتين يهدد بأنه فيما لو آلمت هجمات المقاومة الأوكرانية قواته، مستخدمة هذه الأسلحة الصغيرة، فإنه سيسلّم مثلها للجهاديين، وهو على تماس مباشر معهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد يسلمهم أسلحة من طرازات غربية، يستطيع الاستيلاء عليها من مستودعات القوات الأوكرانية ذاتها.
ترتبط أوكرانيا بأسوأ حادثتي إسقاط للطائرات المدنية في زماننا هذا، هي الطائرة الماليزية التي اسقطت في شرق البلاد العام 2014 بنيران أرضية ثبت أنها روسيّة، وإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية في طهران على يد الحرس الثوري، ومرّ الحدثان من دون عقاب. وكلا الأمرين، الارتباط بأوكرانيا والإفلات من العقاب، جعل سيناريو حرب الطائرات المدنية المشؤوم، يقفز إلى تفكيري ما أن سمعت الإعلام الروسي يتحدث عن جهاديين في أوكرانيا.
المدن
————————–
أين سيلجأ بوتين بعد انتصاره؟/ ياسر هلال
عاجلاً أو آجلاً ستنتهي الحرب بهزيمة عسكرية وسياسية لأوكرانيا وتدمير مدنها وربما اقتطاع أجزاء من أراضيها… ولكن هل ستكون روسيا هي المنتصرة فتفرض شروطها بنزع سلاح أوكرانيا وتحقيق اعتراف دولي باستقلال الجمهوريتين الوليدتين، ورفع العقوبات أو تفريغها من مضمونها ولتتحول إلى قوة عالمية ثالثة تقارع أميركا والصين؟ أم تمنى هي أيضاً بهزيمة سياسية واقتصادية لا تقل قسوة عن هزيمة أوكرانيا. وليكون النصر حليف الصين وأميركا في سياق سعيهما لإعادة تشكيل نظام عالمي ثنائي القطب يقوم على المنافسة في ظل العولمة وليس على الصراع في ظل تقسيم العالم إلى معسكرين.
في زمن التحولات الكبرى واعتبار غزو أوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة على روسيا منعطفاً مهماً في مسار تشكيل النظام الدولي الجديد، تقتضي سلامة التحليل عدم إطلاق أحكام قاطعة والاكتفاء بربط الحقائق بالمعطيات ومن أبرز هذه الحقائق ما يلي:
اليوان الأحمر وليس الكتاب الأحمر
الحقيقة الأولى؛ إقتناع أميركا بأن حقبة القطب الواحد قد انتهت، وان مواجهة الصين لا تتم بإضعافها او احتوائها بالحروب التجارية وتقسيم العالم والتنكر للعولمة كما فعلت إدارة ترامب من خلال شعارات “الأمركة بدل العولمة” و”أميركا أولاً”. فالمواجهة تتطلب إستعادة أميركا لعناصر قوتها الداخلية وإعادة بناء تحالفاتها، لأن المشكلة الحقيقية هي في ضعف أميركا وليس في قوة الصين.
الحقيقة الثانية؛ لا تسعى الصين إلى تغيير النظام الرأسمالي العالمي، كما لا تسعى إلى تقسيم العالم إلى معسكرين، لأنها المستفيد الأول من النظام القائم. وجل ما تسعى إليه هو الفوز بحصة أكبر فيه، تناسب قوتها الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعسكرية أيضاً. وهي لا تخوض صراعاً سياسياً وعقائدياً مع الغرب كما كان حال الاتحاد السوفياتي، فالصين تسعى إلى فرض اليوان الأحمر وليس الكتاب الأحمر.
الحقيقة الثالثة؛ يبدو “الزعيم بوتين” كنغمة نشاز في سيمفونية النظام العالمي الجديد، أولاً لأنه يصر على مواصلة القراءة في كتاب الحرب الباردة وتقسيم العالم إلى معسكرين، وثانياً لأنه “يحلم” بأن النظام الجديد سيكون متعدد الأقطاب وأن روسيا ستكون أحد اقطابه. في حين ان قوتها الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وحتى العسكرية لا تؤهلها لأن تكون أكثر من قوة إقليمية رئيسية يتنافس القطبان على الفوز بها. وبهذا المعنى يصح اعتبار تشجيع الرئيس الأوكراني على المغالاة في استفزاز روسيا وإعلان الغرب عدم الاستعداد للتدخل العسكري لحمايتها، هو “قشرة الموز” التي وضعت تحت أقدام “الزعيم بوتين” لتشجيعه على غزو أوكرانيا، بما يؤدي بالمحصلة إلى إعادة روسيا إلى حجمها الطبيعي ولتختار بأن تلتحق ببيت الطاعة الأميركي أو ببيت الطاعة الصيني.
وبالانتقال إلى ربط الحقائق بالمعطيات والوقائع وبخاصة على صعيد أهداف ومكاسب وخسائر الأطراف الثلاثة المعنية وهي أميركا وروسيا والصين، يمكن ملاحظة ما يلي:
أميركا: الفوز بالجائزة الكبرى
الملاحظ أن أميركا كانت مستعدة سلفاً للتضحية بأوكرانيا، أما الدعم المقدم لها فهو بالقدر اللازم لإطالة أمد الحرب، بل توسيع رقعتها إذا أمكن لتحقيق جملة أهداف أهمها:
1- استنزاف الجيش الروسي وإظهار مواطن ضعفه ودفعه إلى المبالغة في استخدام ما يبرع به وهو قدرته على تدمير المدن والدساكر كما فعل في الشيشان وفي سوريا. ما يؤدي إلى تأليب الرأي العام الأوروبي والعالمي وإحراج الصين. وكل ذلك لتبرير فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وصفها الكاتب توماس فريدمان “بقنبلة نووية”. والهدف هو عزلها وتدمير اقتصادها ولتتراوح سيناريوهات المتاحة أمامها بين تراجعها بعد تسوية تحفظ ماء وجهها بالحد الأدنى، وبين الإطاحة بالرئيس بوتين من قبل الجيش الروسي ونخبة رجال الأعمال المحيطين به بالحد الأقصى.
2- إثارة رعب وحفيظة الدول الأوروبية ما يؤدي إلى: أولا؛ إعادة تعزيز تحالفها مع أميركا الذي بدأ يتداعى بقيادة ألمانيا المغردة خارج السرب. ثانياً زيادة الدول الأوروبية لإنفاقها العسكري وهو الطلب العزيز على قلب أميركا منذ سنوات. وجاءت الاستجابة الأولى الصادمة في سرعتها وعمقها من ألمانيا بالذات بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار لتطوير جيشها. ثالثاً دفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر باعتمادها على روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وجاءت المبادرة الصادمة على لسان المستشار الألماني باعلانه عزم بلاده تقليص واردات الغاز من روسيا وإعادة النظر بسياسة وقف العمل بالمفاعلات النووية، وطبعاً ستتوالي المبادرات المماثلة من دول أخرى.
3- إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط لمحاصرة النفوذ الروسي من خلال دفع تركيا إلى حسم تموضعها إلى جانب حلف الأطلسي، مع وعد أميركي بدعمها لترسيم حدودها البحرية مع اليونان وحل المسألة القبرصية. وهو الأمر الذي يسمح بتركيب حلف يضم تركيا ومصر وإسرائيل ودول الخليج لموازنة النفوذ الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي.
الصين: شريك مضارب بالربح
وضع غزو أوكرانيا الصين في موقف بالغ الحرج، خاصة وأنها ترتبط بتحالف استراتيجي اقتصادي واستثماري ونفطي مع روسيا تم تكريسه خلال اجتماع القمة على هامش الألعاب الأولمبية الشتوية مؤخراً بإعلان “التعاون بلا حدود”. وكان الهدف توظيف قوة روسيا الاقتصادية والسياسية في خدمة الخطط الصينية الكبرى للتنافس الاستراتيجي مع أميركا مثل مبادرة الحزام والطريق وترسيخ موقع اليوان الصيني كعملة تبادل واحتياطي إلى جانب الدولار، والمعايير الفنية للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وليس توريط الصين في صراعات عسكرية تتناقض مع مصالحها وثوابت سياستها الخارجية، التي تركز على الاستقرار ونبذ الحروب، وهو أمر استثمرت فيه الصين والرئيس شي جين بينغ شخصياً وسياسياً وقدمت تنازلات وتضحيات كبيرة لتحقيقه والحفاظ عليه والدليل الأبرز على ذلك “العض على جرح” تايوان، لعقود طويلة. وتجلى هذا الحرج في في مسارعة الصين لإعلان معارضتها لغزو أوكرانيا، كما تجلى في التصويت في الأمم المتحدة.
دعم بالقطارة … والسويفت خير دليل
وعليه يصح الاستنتاج أن مقاربة الصين لدعم روسيا يماثل دعم أميركا لأوكرانيا، فهي لن تدعمها وتحميها من التأثير المدمر للعقوبات إلا بالقدر اللازم للحفاظ على “سيادتها ووحدة أراضيها”، وبالقدر الذي يسهل إلحاقها بالصين كعنصر قوة في سياق المنافسة أميركا. ولكن بشرط ان لا يؤدي هذا الدعم للإضرار بعلاقاتها مع الدول الغربية أو تقويض برامجها لترسيخ موقعها في النظام المالي العالمي. وهذا القدر من المساعدة قد لا تعارضه أميركا لأن استبعاد روسيا بشكل كامل من الاقتصاد العالمي سيكون له نتائج كارثية خاصة على صعيد أسعار النفط والغاز والغذاء، وإطلاق موجة عارمة من التضخم تطيح بالنمو الاقتصادي العالمي.
وبدون شرح طويل للدلالة على تهافت التحليلات الأقرب للتمنيات”، نشير إلى حملة “التطبيل والتزمير” المرافقة للعقوبات المتعلقة بنظام السويفت، ولقدرة روسيا على استخدام النظام الصيني المعروف بإسمCIPS كبديل عنه. فنلاحظ ان الصين لا تعتبر نظامها بديلاً عن النظام الغربي بل منافساً له ومتكاملاً معه. فالنظام الصيني يستعمل حتى الآن منصة السويفت لتبادل تعليمات الدفع، على الرغم من تضمنه منصته الخاصة. وهناك العديد من المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية اعضاء في النظام الصيني مثل ستاندرد تشارترد، دويتشه بنك، إتش إس بي سي، سيتي بنك. يضاف إلى ذلك محدودية نظام CIPS مقارنة بالسويفت إذ يبلغ الأعضاء فيه 75 مشاركاً مباشراً وحوالي 1205 مشاركاً غير مباشر، مقابل 200 دولة عضو وأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نظام السويفت الذي يتم من خلاله تبادل 50 مليون رسالة يومياً بقيمة تقارب 5 تريليون دولار، مقابل 15 ألف رسالة لنظام CIPS.
ولذلك فإن الصين ستبادر إلى مساعدة روسيا في تخطي مصاعب عزلها جزئياً عن السويفت، وذلك بموافقة أميركا التي اكتفت بحرمان عدد محدود من البنوك الروسية من استخدامه، لأنها لا تريد أصلاً عزل روسيا بالكامل، تجنباً لتأثر صادراتها من النفط والغاز. ولتكتمل الصورة، نشير إلى أن الصين ترحب ضمناً بمغالاة أميركا باستخدام الدولار كسلاح لفرض العقوبات، لأن ذلك يسهم في ترسيخ موقع اليوان الصيني كعملة لتسوية المدفوعات وللاحتياطيات إلى جانب الدولار الذي يستأثر حتى الآن بحوالي 60 في المئة من احتياطيات في العالم. وهي تعتمد لتحقيق ذلك تعتمد مخططا مدروساً وفق جدول زمني واضح لترسيخ وجودها كقطب ثان في النظام المالي العالمي، ولا يمكنها القبول بأن يصبح هذا المخطط رهناً بأجندة “الزعيم بوتين” ومغامراته العسكرية.
المدن
————————–

عقوبات على مقربين من بوتين: كيف تمكن أوليغارشيون روس من إخفاء ثرواتهم في الخارج؟
ICIJ – سبينسر وودمان
وجّهت النخبة القريبة من فلاديمير بوتين مليارات الدولارات، من خلال الملاذات الضريبية للتهرب من التدقيق والرقابة. وقد ساهم محامون ووكلاء ومصرفيون في أنحاء العالم في جعل ذلك أمراً ممكناً.
مع تدفُّق القوات الروسية إلى أوكرانيا، بدأت السلطات الغربية جهوداً غير مسبوقة لتحديد أصول تحتفظ بها الأوليغاركا الروسية وآخرون مقربون من النظام وتجميدها.
ووفقاً لبعض التقديرات، فإن نحو 20 في المئة من ثروة البلاد مخبّأة في ظل ولايات قضائية خارجية، مثل قبرص وسيشل وجزر العذراء البريطانية، بل حتى في الولايات المتحدة.
لا تتحرك الأموال أو تختبئ من تلقاء نفسها. فقد حظي هروب الثروات الروسية بدعم البنوك الكبرى وقطاع عالمي من المهنيّين المتخصصين في توفير شركات وهمية وصناديق ائتمانية وغيرها من الوسائل السرية للعملاء الأثرياء.
فعلى مدى ما يقرب من عقدٍ من الزمن، عمل “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (International Consortium of Investigative Journalists)، على الكشف عن المالكين الحقيقيين للكيانات السرية، وكذا عن المهنيين الذين يرتكز عليهم الاقتصاد الخارجي. وقد أدّى هذا الإبلاغ إلى استرداد مليارات الدولارات، وأدّى إلى انهيار إمبراطوريات تجارية، ودفع إلى وضع قوانين جديدة للشفافية. ولكن كان ظهور التغيير المنهجي الحقيقي بطيئاً. فقد غضّت السلطات الغربية الطرفَ، إلى حد كبير، عن الأشخاص والشركات التي تحافظ على استمرارية نظام المال المظلم.
حتى الآن لا يزال “قانون العوامل التمكينية” (ENABLERS Act) عالقاً في الكونغرس الأميركي؛ وهو قانون يتطلَّب من مجموعة كبيرة من المهنيّين، مثل المحامين وتجار الأعمال الفنية، بذلَ العناية والاهتمام الأساسي الواجب بشأن مصادر ثروة عملائهم من النخبة.
فما هي، إذاً، تلك العوامل التمكينية للنظام الخارجي؟ إنها سلسلة من الشركات القانونية العالمية، من أمثال “بيكر ماكنزي”، وهي التي هندست نظام تفادي الضرائب الحديث، إلى مشغّلين صغار من شخص واحد يعملون من برمودا.
وهنا نستعرض طائفة من المسهّلين والوكلاء الخارجيين والبنوك التي استطاع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” تحديد أنها تساعد النخبة الروسية على نقل وإخفاء أموالها.
عوامل التسهيل
أفراد وشركات أُنشِئت أو استخدمت هياكل مالية مبهَمة للنخب الروسية
أليستر تولوش (Alastair Tulloch): تقع شركة “تولوش وشركاه”، التي يديرها المحامي البريطاني أليستر تولوش، في منطقة فخمة في العاصمة البريطانية لندن، وهي إحدى أكثر الوِجهات شهرة لثروة النخبة الروسية. وقد أشار تحقيق “أوراق باندورا”، الذي أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، إلى أن الشركة نظّمت شبكات من الشركات لنائب وزير المالية الروسي السابق أندريه فافيلوف؛ وألكسندر ماموت، أحد المليارديرات من الأوليغاركا الروسية ومن داخل النخبة السياسية؛ وفيتالي زوغين، وهو مصرفي مطلوب في روسيا بتهم احتيال. وقد استخدمت شركة تولوش مزوِّد الخدمات الخارجية “ترايدنت ترست” (Trident Trust)، لترتيب نقل أصولها إلى شركات وهمية مسجلة في جزر العذراء البريطانية وقبرص وجزر البهاما. ولم تردّ الشركة على طلبات التعليق على تلك التفاصيل.
سيرغي رولدوغين (Sergey Roldugin): وجد تحقيق أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” عام 2016 أن رولدوغين، وهو صديق طفولة روسي لبوتين وعازف تشيللو كلاسيكي، كان وراء الكواليس في شبكة سرية يديرها مرتبطون ببوتين، مزجَت ما لا يقلّ عن مليارَي دولار من خلال البنوك والشركات الخارجية. وفي أثناء كتابة التقرير، لم يردّ رولدوغين على أسئلة تفصيلية من غرف أخبار كثيرة. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رولدوغين راهناً، مستشهداً بنتائج توصّل إليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.
بيتر كولبين (Peter Kolbin): وهو من أصدقاء بوتين القدامى، وتعتقد السلطات الأميركية أنه يدير مئات الملايين من الدولارات للرئيس الروسي. ويتّضح من سجلّات “أوراق باندورا” أن كولبين “غيَّر الملكية المسجّلة للشركات الخارجية مع فرْض العقوبات” على الروس عام 2014، وَفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، وهي من شركاء “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين”. ولم نستطع الوصول إلى كولبين للتعليق، وليس من المؤكد إن كان لا يزال على قيد الحياة.
مورس رولاند (Moores Rowland): تربط الوثائق التي اطّلع عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” وشركاه بين سفيتلانا كريفنوغيخ، وهي امرأة يُزعَم أنها في علاقة سرية منذ سنوات مع بوتين، وبين شقة فاخرة في موناكو. وقد استخدمت شركة مورس رولاند- وهي شركة خدمات مالية في موناكو كانت تدير المعاملات المالية المتعلقة بالشقة- شركاتٍ وهمية كانت تُصعّب مهمة أي شخص يسعى إلى كشف ملكية العقار، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”. وقد أُدخِلَت إحدى الشركات الوهمية المعنية داخل شركة وهمية أخرى، كانت بدورها مملوكة لإيمون ماك غريغور (Eamonn McGregor)، وهو محاسب بريطاني المولد يدير شركة “مورس رولاند” في موناكو، بحسب ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”. وفي رسالة إلى الصحيفة، دافعت شركة محاماة بريطانية تمثّل شركة “مورس رولاند” عن عميلتها، ولكنها لم تقدم أي تعليق للنشر.
أما غينادي تيمتشينكو (Gennady Timchenko)، الملياردير في الدائرة القريبة من بوتين التي نالتها عقوبات السلطات البريطانية في الفترة الأخيرة، فقد كان أيضاً من عملاء شركة “مورس رولاند”، واستخدم أحد المساهمين المرشحين أنفسهم. وقال محامو تيمتشينكو إن أي صلة بينه وبين كريفنوغيخ قد “أُسيء فهمها”.
ماركوم للإدارة (Markom Management / Mark Omelnitski): هذه الشركة يملكها ويديرها مارك أوميلنيتسكي، الذي يعرّفه تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي بأنه محامٍ يقيم في لندن. وترتبط شركة “ماركوم” بأعضاء في الدائرة المقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممن نالتهم العقوبات، وهم أركادي وبوريس روتينبيرغ. وفي تقرير عن الأنشطة المشبوهة، صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قال بنك باركليز إنه وضع علامات على 3 تحويلات مصرفية يبلغ مجموعها نحو 114 ألف دولار بين عامَي 2013 و2016، لاعتقاده أن الأموال تتدفق إلى شركة وهمية يملكها رجل أعمال على صلة بأركادي روتينبيرغ.
قام أوميلنيتسكي وشركته “بإنشاء شركات وهمية لشخص شملته العقوبات، وهو أركادي روتينبيرغ”، كما جاء في المذكرة الاستقصائية الصادرة عن بنك باركليز، التي اقتطف منها تقرير مجلس الشيوخ الأميركي. وأضافت المذكرة “يبدو أن ملكية هذه الشركات الوهمية مهيكلَة عمداً لتصبح غامضة، لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين”. وقد رفض أوميلنيتسكي التعليق من خلال محامِِ.
عملاء خارجيون
شركات أنشَأت شركات وهمية وصناديق ائتمانية ومنتجات مالية سرية أخرى للأثرياء الروس في الملاذات الضريبية:
صندوق آسيا سيتي (Asiaciti Trust): وهو شركة مقرها سنغافورة، وتنفذ عمليات أيضاً في نيوزيلندا وجزر كوك وساموا وأماكن أخرى. وقد قامت شركة “آسيا سيتي” بإنشاء وإدارة صناديق ائتمانية وشركات وهمية في ظل ولايات قضائية سرية للآلاف من العملاء من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وفقاً لما ورد في “أوراق باندورا”. وساعدت الشركة كيريل أندروسوف، وهو من كبار مساعدي بوتين سابقاً، بهيكلٍ إداري استحوذ من خلاله على شركة يَدِين لها الأوليغاركي الروسي أوليغ ديريباسكا بمئتَي مليون دولار، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وفي بيان مكتوب، أنكرت “آسيا سيتي” أي مخالَفات ورفضت مناقشة تعاملاتها مع أندروسوف.
أبل بَاي (Appleby): وهي شركة محاماة خارجية عالمية، وعضو في “الدائرة السحرية الخارجية” (Offshore Magic Circle)، وهي مجموعة من أبرز المتخصصين في القوانين (الممارسات القانونية) الخارجية. تأسست الشركة في برمودا، ولها مكاتب في هونغ كونغ وشانغهاي وجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وغيرها من مراكز التهرب الضريبي. وتُظهِر سجلّات تحقيق “باراديز بيبرز” (وثائق الجنة)، الذي أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، كيف أن ويلبور روسّ، وزير التجارة في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، استخدم سلسلة من الكيانات الواقعة في جزر كايمان للحفاظ على حصة مالية في شركة نافيغاتور القابضة، وهي شركة شحن من أكبر عملائها شركة سيبور (Sibur) للطاقة، وهي شركة لها صلة بالكرملين. ومن بين أبرز مالكي شركة “سيبور”، هناك كيريل شامالوف، صهر بوتين، وغينادي تيمتشينكو، وهو ملياردير روسي فرضت الحكومة الأميركية عقوبات عليه في 2014 بسبب صلاته ببوتين. وكانت سيبور عميلاً رئيساً لشركة نافيغاتور، ودفعت لها أكثر من 23 مليون دولار عام 2016.
ولم ترُدّ أبل بَاي على أسئلة تفصيلية طرحها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” في وقت كتابة هذا التقرير، ولكنها أصدرت بياناً على الإنترنت يقول إنها حقّقت في أسئلة “الاتحاد”، وإنها “راضية عن عدم وجود أدلة على أي مخالفات”. وقال متحدث باسم روسّ في ذلك الوقت إنه لم يلتقِ أبداً صهرَ بوتين أو المالكين الآخرين لشركة “سيبور”، وإنه لم يكن عضواً في مجلس إدارة شركة نافيغاتور عندما بدأت علاقتها مع شركة “سيبور”.
ألفا المحدودة للاستشارات (Alpha Consulting Limited): تأسست عام 2008، وهي مزوِّد خدمات خارجي، ولها مكاتب في سيشل والإمارات العربية المتحدة وبِليز. و75 في المئة من قاعدة عملاء ألفا هم من الروس، وفقاً للتقرير السنوي للشركة عام 2019. ومن عملاء ألفا رومان أفدييف، وهو ملياردير روسي ورد اسمه في تقرير وزارة الخزانة الأميركية لعام 2018 المُقدَّم إلى الكونغرس حول الأوليغارشيين والشركات التي تعتبرها مقرَّبة من بوتين.
وفي ردّ على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، قالت ألفا إنها مُنِعَت بموجب القانون من الدخول في مناقشات حول العملاء. وأضافت الشركة “منذ بدء (ألفا للاستشارات) أعمالَها التجارية عام 2008، تمتثل الشركة للمتطلّبات القانونية المحلية والدولية”.
ديميتريوس ايه ديميترياديس (Demetrios A. Demetriades): وهي شركة محاماة قامت بالترويج لقبرص باعتبارها المركز الخارجي المفضَّل للأموال المتدفّقة خارج روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وأكثر من 30 في المئة من الشركات الواردة في “أوراق باندورا” التي تلقّت خدمات من الشركة، المعروفة اختصاراً باسم DADLAW، لديها مالك مستفيد أو أكثر من الروس. ومن عملائها مسؤولون عموميون ومحتالون متهمون ورجال أعمال خاضعون للعقوبات من روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية السابقة.
وعلى غرار كثر من مقدمي الخدمات الخارجية الآخرين، تستغل الشركة قوانين البلد المضيف التي تنظم الضرائب والسرية، ما يسمح لها بمساعدة العملاء على إخفاء الأصول من السلطات الأجنبية. إذ تضطلع بتسجيل الشركات الوهمية، فضلاً عن إنشاء الصناديق الائتمانية وإدارتها، وتوفر حملة أسهم “مُعينين”- وهم أشخاص بدلاء يتلقون الأموال مقابل تمثيل الملاك الحقيقيين في الأوراق الرسمية. ولم ترد الشركة على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.
البنوك
المؤسسات المالية التي ساعدت الأثرياء الروس في تهريب الأموال
بنك “إتش إس بي سي” (HSBC): واجه بنك “إتش إس بي سي” الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ادعاءات في الكثير من الدول بأنه يوفر حسابات مصرفية للمجرمين. وقد أجرى “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” وموقع “بازفيد نيوز” الإخباري بحثاً معمقاً في وثائق فنسن (FinCEN Files) حول تورط البنك في الأموال المشبوهة، بما في ذلك الأموال الروسية. ووفقاً للمراجعة التي أجراها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” للبيانات التي جمعها “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، فقد اعتمد البنك شركة وهمية مثلت نقطة رئيسية في شبكة “غسل الأموال الروسية” الواسعة التي هربت الأموال الملوثة بسبب الأعمال الإجرامية من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الدول الغربية. وبين عامي 2012 و2014، أجرى البنك عمليات تحويل بقيمة 581 مليون دولار أميركي من حسابات شركة وهمية في هونغ كونغ وإليها، برغم أن موظفي الامتثال في البنك لم يدركوا من وراء تلك الشركة الوهمية، بحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”. وقد صرح البنك في بيان له أنه “شرع في رحلة استمرت سنوات لإجراء إصلاح شامل لقدرته على مكافحة الجرائم المالية. وأن بنك (إتش إس بي سي) صار مؤسسة أكثر أماناً مما كان عليه عام 2012”.
دويتشه بنك (Deutsche Bank): اضطلع “دويتشه بنك” بدور مهم في ما يعرف بفضيحة التداول المتطابق الروسية، وهي شبكة هائلة لنقل الأموال استخدمت أساليب مقايضة الأوراق المالية المعقدة لنقل المليارات من الأموال المشبوهة خارج البلاد. وكشف التحقيق في “وثائق فنسن”، أن “مُدِيري دويتشه بنك، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين، كانوا على دراية مباشرة لسنوات بإخفاقات خطيرة أضعفت البنك في مواجهة من يقومون بغسل أموال”، وفقاً لتقرير نشره موقع “بازفيد نيوز”، الذي يتعاون مع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”. “وتظهر الوثائق تحذيرين أُرسلا إلى اللجان المعنية، بما في ذلك باول أخلايتنر، رئيس مجلس إدارة البنك، وآخر أرسل إلى مجلس الإشراف في البنك”، بحسب موقع “بازفيد نيوز”. وأفاد البنك في معرض رده على أسئلة الصحافيين، بأنه اعترف بوجود “نقاط ضعف في السابق” و”أننا تعلمنا من أخطائنا”، بينما يستثمر مئات الملايين من الدولارات لتعزيز دفاعاته ضد الجرائم المالية، وفقاً لموقع “بازفيد نيوز” الإخباري.
دانسك بنك (Danske Bank): عام 2018، تورط “دانسك بنك” في فضيحة كبرى تتمحور حول مزاعم قيامه بتسهيل غسل مئات المليارات من الدولارات من روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفييتي السابق. وقد كشفت تقارير أعدها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” منذ عام 2021 عن الخطوات الاستثنائية التي اتخذها قسم صغير في البنك لخدمة العملاء الغامضين الذين يدرون أرباحاً طائلة على البنك، من روسيا ومن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق والفروع (التابعين) في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وتبين الوثائق أن الكثير من الحسابات المصرفية، كانت محفوظة باسم كيانات (آليات) في المملكة المتحدة، المعروفة باسم “الشراكات ذات المسؤولية المحدودة”، و”الشراكات المحدودة”، التي لم يكن لها أي غرض سوى إخفاء هوية الملاك الحقيقيين للأموال. ولم يرد الكثير من المصرفيين السابقين في القسم المعني لـ”دانسك بنك” الذي تسبب في هذه الأزمة على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.
ساهم ويل فيتز
غيبون في إعداد هذا التقرير.
هذه المادة مترجَمة عن هذا الرابط.
درج
——————————-
لتعويض نقاط الضعف في قدرات القوات البرية: من الشيشان إلى سوريا إلى أوكرانيا: موسكو ترد على المقاومة بالقوة المدمرة
– بي. بي. سي.
من الشيشان إلى سوريا إلى أوكرانيا: موسكو ترد على المقاومة بالقوة المدمرة
وقت كتابة المقال، لم يكن وسط العاصمة في كييف قد تأثر بالحرب بشكل كبير، وإن كانت صفارات الإنذار والإشعارات تنطلق على فترات متقطعة خلال اليوم.
الكل هنا يعرف أن ذلك من الممكن أن يتغير بسرعة كبيرة، وربما يكون قد تغير بالفعل وقت قراءتكم لهذه السطور.
وقد تعرضت خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، لأهوال الأسلوب الروسي في الحرب. الشيء ذاته حدث في ماريوبول وغيرها من المدن في شرق البلاد.
ترد روسيا على المقاومة بالمزيد من القوة النارية. وبدلا من إرسال الجنود من منزل لآخر، ومن غرفة لأخرى، العقيدة العسكرية لموسكو ترتكز إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي لتدمير الأعداء.
تعرضت خاركيف وغيرها من المدن والبلدات لأضرار مادية جسيمة، وعلى حد معلوماتنا، الكثير من الخسائر في الأروح المدنية أيضا. وقد أدى استهداف مقر حكومة خاركيف المحلية بهجوم صاروخي تم تصويره بالفيديو إلى تعرضه لضرر هائل. لربما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبعث برسالة إلى كييف مفادها: انظروا إلى الشرق، لأن ما يجري هناك قد يحدث لكم.
الاستنتاج المحبط الذي توصلت إليه من حروب أخرى كنت شاهدا فيها على التصرفات الروسية، هو أن الأمور قد تسوء بدرجة كبيرة.
“الأرض كانت تهتز”
حتى الآن، لم يعط السيد بوتين الأوامر لقواته بإحداث ضرر مماثل لما فعلته في غروزني خلال تمرد جمهورية الشيشان في التسعينيات، أو في سوريا عندما تدخلت القوات الروسية في الحرب السورية عام 2015.
قمت بتغطية حرب الشيشان الأولى عندما بدأت في فصل الشتاء عامي 1994 و 1995. وكما يحدث في أوكرانيا، ارتكب الجيش الروسي أخطاء فادحة في العمليات البرية. ونصب المتمردون الشيشان كمائن لأرتال المدرعات الروسية في الشوارع الضيقة ودمروها. والكثير من الروس المجندين إلزاميا لم يكونوا يريدون القتال والموت.
قبيل الغزو الأوكراني، ذكر محللون عسكريون أن القوات الروسية الآن أكثر حرفية بكثير مما كانت عليه إبان حرب الشيشان. ربما تكون كذلك، ولكننا نشهد من جديد بطء تقدم الجيش الروسي بسبب العقبات اللوجستية والأخطاء التكتيكية والجنود المراهقين المذعورين الذين لم يخبرهم أحد بأنهم سيخوضون حربا، فضلا عن المقاومة الأوكرانية التي تضاهي في شراستها مقاومة الشيشان للروس عام 1995.
أوكرانيا تقول إن روسيا تقصف المدارس والمستشفيات
بلينكن يؤكد من ليتوانيا وقوف البلدين مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي
أعلنت الشيشان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ثم غزتها القوات الروسية في عام 1994. القصف الذي تعرضت له غروزني كان عنيفا
في الشيشان، كان الحل الروسي هو القصف المكثف. في غضون بضعة أسابيع، أدت الغارات المدفعية والجوية إلى تحويل وسط غروزني، والتي كانت مدينة تهيمن عليها المباني المصنوعة من الصلب والخرسانة كباقي المدن السوفيتية، إلى مجرد أنقاض. كنت في ميدان مينوتكا، مركز المقاومة الشيشانية، في نفس اليوم الذي تعرض له لغارات جوية متكررة. كان أغلب المدنيين يحتمون في الأقبية، وكانوا يخاطرون بحياتهم في كل مرة يخرجون فيها للعثور على المياه أو الطعام.
في ميدان مينوتكا في ذلك اليوم، لقي المقاتلون الشيشان حتفهم بالقنابل العنقودية، وأضرمت النيران في المباني. بعد ذلك بأربع وعشرين ساعة، تعرض الطريق الرئيسي بالمدينة بالكامل للقصف الصاروخي، وغطته ألسنة النار والدخان. شعرنا حينذاك بأن الأرض كانت تهتز في مكان التصوير.
هجوم مكثف من الجو
أسوأ الأماكن المدمرة التي رأيتها، باستثناء غروزني، كانت في سوريا. العامل المشترك بينها جميعا هو القوة العسكرية الروسية المدمرة.
قرار السيد بوتين التدخل في سوريا أنقذ نظام بشار الأسد من الانهيار، وكان بمثابة خطوة كبيرة على طريق تحقيق هدفه المتمثل في استعادة روسيا لمكانتها كقوة عالمية. وقد تمكن النظام السوري من تحقيق انتصارين حاسمين على المعارضة المسلحة بفضل القوة العسكرية الروسية العنيفة.
الأول كان في حلب أواخر عام 2016. فقد سقط الجزء الشرقي من المدينة، والذي كان خاضعا لسيطرة عدد مختلف من فصائل المعارضة خلال الحرب، بعد أن سحقته الغارات الجوية والقصف المدفعي. لم يكن نظام الأسد بحاجة إلى من يشجعه على قصف السوريين، لكن الروس جلبوا معهم مستوى أعلى بكثير من القوة المدمرة. وقامت الطائرات المقاتلة الاستراتيجية الموجودة في قواعد سورية وإيرانية بشن غارات مكثفة.
تركزت التكتيكات في سوريا على إحاطة ومحاصرة المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وقصفها من الجو ومن بطاريات المدفعية، ما يؤدي في النهاية إلى إرهاق القوات المدافعة وأي مدنيين لم يتمكنوا من الفرار. وقد لقي كثير من هؤلاء حتفهم.
لماذا استمرت الحرب السورية 10 سنوات؟
عندما تمكنت من قيادة السيارة في شوارع حلب بعد أسابيع من سقوطها، كان الدمار منتشرا في كل مكان. لم أر منزلا واحدا لم يلحق به الضرر. أحياء بأكملها تحولت إلى حطام. وكانت الأنقاض تبدو وكأنها سلاسل جبلية.
شاهدت التكتيكات ذاتها في الغوطة الشرقية، وهي سلسلة من البلدات والأراضي الزراعية التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على أطراف العاصمة السورية. كان استسلامها في عام 2018 هو نهاية المعركة الرامية إلى السيطرة على دمشق، والتي كانت تبدو في بادئ الأمر وكأنها ستنتهي لصالح المتمردين. تغير ذلك بعد أن قررت الولايات المتحدة في عام 2013 عدم توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد عندما استخدم أسلحة كيميائية في دوما، إحدى البلدات في المنطقة. المعركة الطويلة كانت في صالح النظام بعد دخول روسيا على خط الحرب الأهلية السورية عام 2015.
قام المدافعون عن الغوطة الشرقية بحفر أنفاق تحت الأرض لجأوا إليها هروبا من الغارات الجوية والقصف المدفعي. لكن الحصار والقوة النارية الطاغية يؤديان إلى كسب المعارك، ذلك لأن المدافعين يتعرضون للقتل والاستنزاف، ويشعر المدنيون بخوف وبؤس شديدين، لدرجة تجعلهم يرحبون بالهدوء الذي ينتج عن الاستسلام.
في كييف، أحد أهم الأسئلة التي تدور في ذهن الجميع هو ما إذا كانوا سيتعرضون لنفس المعاملة التي لم تواجهها خاركيف وماريوبول وغيرهما من المدن الأوكرانية فحسب، بل الشيشان وسوريا أيضا.
هل ستخلق حرمة الأماكن الأورثوذكسية المقدسة حالة من ضبط النفس كانت غائبة خلال الهجمات في الشيشان وروسيا ذواتي الأغلبية المسلمة؟ بوتين نفسه سبق وأن كتب عن أهمية أوكرانيا في التاريخ الروسي. فهل سيكون مستعدا لتدمير أوكرانيا من أجل أن يستعيدها؟ إذا ما شكلت العقوبات والمقاومة الأوكرانية تهديدا على استقرار نظامه، هل سيدفعه ذلك إلى اتخاذ إجراءات مفرطة؟
سجل الجيش الروسي يظهر أنه يعوض نقاط الضعف في قدرات قواته البرية من خلال اللجوء إلى الأسلحة المدمرة. ويأمل الأوكرانيون ألا يحدث ذلك هنا.
———————————-
إمبريالية جديدة أم تمزق محتمل؟… مستقبل روسيا على المحك بعد الأزمة الأوكرانية
باحث بريطاني يعتبر أن أي انقسام روسي ستستفيد منه الصين
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
بعد نحو أسبوعين من قرار غزو روسيا لأوكرانيا، لا يزال الوضع يحمل قدراً كبيراً من الغموض فيما يتعلق بأفق العمل العسكري ونهايته وتداعياته سواء على روسيا نفسها أو محيطها والعالم ككل.
ويقول الباحث البريطاني يانوش بوجاجسكي، وهو أحد كبار الزملاء في مؤسسة جيمس تاون في واشنطن العاصمة ومضيف برنامج تلفزيوني بعنوان «ساعة بوجاجسكي» يُبث في البلقان، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنتريست، إن موسكو تمثل تحدياً مزدوجاً للغرب، ما بين طموحاتها الإمبريالية الجديدة، كما يتضح من الغزو الشامل لأوكرانيا، بجانب الاحتمال الذي يلوح في الأفق لتمزق الدولة الروسية. وفي حين تمت كتابة الكثير عن توسع موسكو، كان الاهتمام أقل بالنسبة للركائز الهشة للاتحاد الروسي.
ويرى بوجاجسكي أن العاملين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، حيث سيصبح الكرملين أكثر عدوانية دولياً لإخفاء تصدعاته الداخلية. وأقنعت المشاكل الداخلية المتصاعدة موسكو بأن استراتيجية السياسة الخارجية الأكثر جرأة وخطورة يمكن أن تحقق فوائد محلية من خلال حشد المواطنين حول «روسيا الحصينة» وإسكات المعارضة. ومع ذلك، فإن هذا سوف يرتد ضد النظام إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا بشكل مكلف مع فرض عقوبات شديدة. وإن إعادة الإمبريالية والتشرذم على حد سواء سيواجهان التحالف الغربي بقرارات سياسية حاسمة في ردع هجمات روسيا والدفاع عن نفسها مع التعامل مع زوال روسيا كدولة واحدة في الوقت نفسه.
واتبع الكرملين سياسة استعادة الإمبريالية من خلال تقسيم الدول على طول حدوده، وتقويض النفوذ الأميركي في أوروبا، وتقويض حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتحسر الرئيس فلاديمير بوتين على انتهاء الاتحاد السوفياتي ليس فقط باعتباره كارثة، بل وأيضاً باعتباره زوال «روسيا التاريخية».
وينظر الكرملين إلى «قطب قوته» على أنه يتكون من أوراسيا، أو الكتلة الأرضية لشمال أوراسيا، وأكبر قدر ممكن من أوروبا، وخاصة تلك المناطق التي كانت جزءاً من المجال الروسي في الحقبة السوفياتية أو حتى القيصرية.
ويقول بوجاجسكي إنه بخلاف الدول الإمبريالية الأخرى التي تخلصت وحررت نفسها من إمبراطورياتها في الخارج، تحتاج روسيا إلى التحرر من نفسها.
فأصبحت روسيا إمبراطورية قبل أن يصبح الروس أمة وقبل أن تتطور روسيا إلى دولة قومية. وركزت روسيا كإمبراطورية على حجمها الإقليمي وأهملت إلى حد كبير بناء الأمة. وتوسعت بشكل متجاور من خلال دمج العديد من المجموعات العرقية التي لا يمكن استيعاب هوياتها الوطنية بالكامل وإضفاء الصبغة الروسية عليها. وحتى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، كانت الأراضي التي خسرتها موسكو أصغر من تلك التي استسلمت لها الإمبراطوريات الغربية بعد إنهاء الاستعمار.
ورغم الخطابات والأفعال الحازمة، فشل بوتين في تحويل روسيا إلى «قطب قوة» رئيسي أو مصدر حقيقي للجذب السياسي والاقتصادي والثقافي للدول المجاورة.
ويرى بوجاجسكي أن غزو دول الجوار والتهديدات ضد الدول الغربية ليست علامات على القوة ولكنها إحباط في إخضاعها. وبدلاً من النجاح في بناء الإمبراطورية، قام نظام بوتين باقتطاع أجزاء من الدول المجاورة، لكنه فشل في اكتساب الشرعية الدولية لعمليات الاستحواذ عليها. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الاتحادات الطوعية، فإن غزو الدول يزيد من الأعباء الاقتصادية والأمنية على المركز في ظل فوائد محلية قصيرة الأجل فقط للتعبئة الوطنية.
ويصف بوجاجسكي الاتحاد الروسي بأنه أيضاً «دولة فاشلة» أقيمت لتخلف الاتحاد السوفياتي ولكنها تواجه تحديات معوقة لبقائها. وفي العقود الثلاثة الماضية، أثبتت محاولات تحويل روسيا إلى دولة قومية أو دولة مدنية أو دولة إمبريالية مستقرة عدم جدواها.
ويضيف أن الانحدار المتسارع للدولة الروسية وظهور كيانات شبه مستقلة سيتحدى قدرة حلف الناتو على الرد. ولا يمكن افتراض أن تصدع روسيا سيكون سريعاً من خلال انهيار مفاجئ للحكومة أو من خلال ثورة على مستوى الدولة.
ومن المرجح أن تكون عملية متطورة تتسارع في المنعطفات الحرجة. ويمكن أن تشمل دوافع التمزق محاولة نقل السلطة من قبل بوتين إلى خليفة له، أو احتجاج متفجر ضد الفقر الاقتصادي، أو صدام عرقي يتصاعد إلى صراع أوسع، أو استفزاز عنيف من قبل المتشددين أو القوميين يفلت من سيطرة الشرطة، أو تمرد في الجيش نتيجة للحرب الفاشلة في أوكرانيا، أو اشتباكات داخل الجيش على أساس الولاء العرقي.
وسيؤثر تمزق الدولة أيضاً على الدول المجاورة. وسيكون البعض عرضة لامتداد الصراع أو عرضة لاستفزازات موسكو في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تحويل الانتباه عن الاضطرابات الداخلية. وستستفيد دول أخرى من الانقسامات الروسية من خلال تخفيف مخاوفها الأمنية واستعادة الأراضي المفقودة. وسيؤثر الانهيار الاتحادي أيضاً على مواقف واستراتيجيات القوى الكبرى، ويمكن أن يؤدي إلى عمليات إعادة تنظيم استراتيجية كبيرة تزيد من مكانة الصين.
ومن دون التحديث والتنويع الاقتصاديين بالاقتران مع التحول الديمقراطي واللامركزية والنظام الاتحادي الحقيقي، فإن روسيا سوف تنزلق نحو أزمة وجودية، وفقاً لبوجاجسكي.
ويرى أخيراً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تطوير استراتيجية استباقية لإدارة زوال روسيا من خلال دعم الاتجاهات الإقليمية والاتحادية، والاعتراف بالتطلعات إلى السيادة والانفصال، وتحديد موقف القوى الكبرى الأخرى، وتطوير الروابط مع كيانات الدولة الوليدة، وتعزيز أمن الدول المتاخمة لروسيا، وتعزيز الاتجاهات عبر الأطلسي وعبر المحيط الهادي بين الدول الناشئة.
ويختتم بوجاجسكي تقريره بقوله: «إن إهمال فشل الدولة الروسية قد يكون أكثر ضرراً بالمصالح الغربية من الاستعداد لإدارة تداعياته الدولية. إن الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثين عاماً لا بد أن يكون بمثابة درس يفيد بأن الثورات الجيوسياسية تحدث بغض النظر عن إنكار الكرملين أو تمسك الغرب بالوضع الراهن».
الشرق الأوسط
—————————————–
النار في كييف.. الحصاد في دمشق/ زينب مصري، ديانا رحيمة، أمل رنتيسي و حسن إبراهيم
يؤثر “الغزو” الروسي لأوكرانيا الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأيّده رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على الوضع في سوريا على عدة أصعدة سياسية واقتصادية وعسكرية.
وترتبط العديد من الملفات التي تُفتح في أوكرانيا بين الدول الكبرى والملف السوري تبعًا لارتباط علاقات هذه الدول ومصالحها التي تلعب دورًا أساسيًا في الساحة السورية، وهي أمريكا وروسيا وتركيا وإسرائيل.
كما يؤثر هذا الغزو على الوضع الاقتصادي في سوريا بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب عالميًا وارتفاع التضخم وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه روسيا لحكومة النظام، والعقوبات الاقتصادية التي تواجهها من الدول الغربية وانعكاسها على سوريا، وكون أوكرانيا بلدًا مصدّرًا لمنتج استراتيجي، القمح.
تناقش عنب بلدي في هذا الملف مع خبراء سياسيين واقتصاديين تداعيات “الغزو” الروسي لأوكرانيا على سير العملية السياسية المتعلقة بالملف السوري، وعلى الوضع الاقتصادي في سوريا على اعتبار روسيا حليفًا أساسيًا للنظام، وطرفًا فاعلًا في القضية السورية.
“شعرة معاوية انقطعت”
انعكاسات سياسية في سوريا
قامت مقاربة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، “خطوة بخطوة” التي طُرحت لإيجاد حل سياسي لسير العملية السياسية في سوريا على أساس توافق روسي- أمريكي.
وفي كانون الثاني 2022، قال بيدرسون في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة “خطوة بخطوة” بين الأطراف المعنية، لتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق لتطبق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولًا إلى القرار الدولي “2254”.
ولكن التصعيد بين الدولتين العظميين الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يوحي باستمرار هذا التوافق على نحو جيد، حتى إن بيدرسون نفسه أعرب، في 23 من شباط الماضي، عن قلقه من أن يؤثر الصراع الروسي- الأوكراني سلبًا على حل الأزمة السورية.
وقال بيدرسون خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، “بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
تصعيد لا تقارب
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في بيان بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه ندد بـ”الهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة، و”سيحاسب العالم روسيا (…) المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستقدم ردًا قويًا على العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، أنه “يجب ألا تكون هناك شكوك من أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة مماثلًا، ولكنه سيكون محسوسًا بالنسبة للجانب الأمريكي”، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”.
ويرى الباحث في الشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف، أن التسوية السورية صارت أمرًا مؤجلًا حاليًا لـ”انقطاع شعرة معاوية” التي كانت تربط بين الروس والغرب الجمعي، بحسب ما قاله لعنب بلدي.
وإذا كانت روسيا سابقًا أرادت أن تقدم تنازلات مقابل الحصول على أشياء أخرى في الملفات الخلافية، فالأمر صار مؤجلًا تمامًا، نظرًا إلى العداء الذي انفجر بين عشية وضحاها بين روسيا والغرب.
وبالتالي فإن الأزمة السورية ستطول، وانعكاسات الأزمة الأوكرانية سيئة جدًا على سوريا، بحسب الباحث.
وكثّفت روسيا من وجودها على الأرض السورية كمًا ونوعًا بجلبها للطائرات الاستراتيجية والطائرات القاذفة الحاملة للصواريخ، إلى جانب المناورات البحرية لفتح جبهة تشمل أوروبا والشرق الأوسط.
ويرى اليوسف أن روسيا لن تتخلى عن سوريا كلها لأنها عبارة عن نقطة انطلاق لها، إضافة إلى أنها صارت قاعدة روسية يمكن أن تُستخدم في مواجهة الغرب.
ومن ناحية أخرى، لن يضحي بوتين بالأسد الذي يستجيب مع أوامر بوتين مباشرة، و”ليس من المعقول أن يستبدله بوتين في هذه الفترة العصيبة الحساسة، وهو يعرف مدى إخلاصه وطاعته لروسيا”.
وبحسب اليوسف، دخلت “الأزمة السورية” في نفق إن لم يكن مظلمًا فعلى الأقل ليس فيه ما يبشر.
أوراق لا تريد تركيا أن تخسرها
اتخذت تركيا، صاحبة التأثير والتي تقف على طرف نقيض من روسيا في سوريا، دور الوسيط قبل بدء “الغزو” الروسي، وأبدت تعاطفها مع أوكرانيا، مع المحافظة على علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا.
وفي 22 من شباط الماضي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موقف تركيا الرافض للاعتراف بكل من دونيتسك ولوغانسك، بحسب بيان لـ”الرئاسة التركية”.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا أعلنت عن موقفها من خلال بيان وزارة خارجيتها، مؤكدًا أن اعتراف بوتين بالجمهوريتين المزعومتين “غير مقبول”.
من جهته، أعرب بوتين عن “خيبة أمله” من رد أمريكا وحلف شمال الأطلسي، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع أردوغان.
وفي أعقاب الهجمات الروسية على أوكرانيا، طلب السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيل بودنار، من تركيا إغلاق مضايقها البحرية أمام السفن الروسية لمصلحة أوكرانيا.
وبعد إنكار تركي حكومي لتأكيد قرار إغلاق المضايق أمام الروس أو نفيه، أعلنت تركيا، في 28 من شباط الماضي، أن أنها أخطرت جميع الدول بعدم إرسال سفنها الحربية عبر المضايق التركية.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في وقت سابق، إن روسيا ستظل قادرة على إرسال سفنها (إلى قواعدها في البحر الأسود) عبر المضايق حتى لو قامت تركيا بإغلاقها.
ما الذي تملكه روسيا
تعتمد تركيا في استيرادها للغاز على روسيا بشكل كبير، واستوردت ما يقارب 33.6 مليار متر مكعب لعام 2020 فقط.
وأدى توقف تدفق الغاز من إيران إلى تعطل بالقطاع الصناعي في تركيا، وشلل الصناعة التركية لعدة أيام.
المدير التنفيذي لشركة الغاز التركية “غاز داي”، محمد دوغان، قال، “إذا نظرنا إلى أسوأ الاحتمالات، وتصاعد الصراع الروسي- الأوكراني خلال الصيف، وقامت روسيا بوقف تصدير الغاز لنا، فإن أسعار الغاز ستقفز بشكل كبير، ولكن إذا وقع ذلك خلال الشتاء، فإنه لن تكون أمام تركيا أي فرصة. سنكون قد انتهينا”.
رأت تركيا منذ اللحظة الأولى في الأزمة أضرارًا بالغة عليها، وعليه سعت منذ البداية لمحاولة تجنب تفاقم الوضع، بما في ذلك عرضها الوساطة بين موسكو وكييف، بحسب ما قاله الباحث والمختص بالشأن التركي الدكتور سعيد الحاج، في حديث إلى عنب بلدي.
وتوجد انعكاسات متوقعة لأي تصعيد عسكري على الاقتصاد العالمي وخصوصًا على الاقتصادات النامية، ظهر بعضها في عمل البورصات وأسعار الصرف وغيرها من المؤشرات منذ بدء الغزو، وهي انعكاسات مقلقة لتركيا في ظل ظروف الاقتصاد التركي حاليًا ومحاولات الحكومة الخروج منها.
كما أن الارتدادات على موسم السياحة مع بداية الصيف ستكون كبيرة، فهو موسم تعوّل عليه تركيا كثيرًا في تشغيل اليد العاملة والحصول على عملة صعبة وتنشيط الاقتصاد، خصوصًا أن روسيا تحتل عادة المرتبة الأولى أو الثانية من حيث عدد السياح القادمين إلى تركيا.
ترغب تركيا في تجنب الاضطرار لاتخاذ مواقف حادة ومنحازة في أزمة كهذه قد تكون لها تبعات، وتخشى أنقرة من ارتدادات أي موقف لها على صعيد العلاقة مع موسكو أو في ملفات إقليمية مثل سوريا وليبيا وجنوب القوقاز كخطوات روسية “انتقامية”.
وحاولت قدر الإمكان تجنب تحول الأزمة الأوكرانية إلى صراع عسكري، وحين وقع الأخير فقد رفضته ونددت به، لكن دون أن تستعدي روسيا أو تقف في مواجهتها، لإدراكها أن أمريكا (والغرب عمومًا) ستعود غالبًا للجلوس مع بوتين للتفاوض في وقت لاحق بعد هدوء الأزمة.
ولا يرى الحاج أن تركيا رفضت بشكل أساسي الحرب الروسية ضد أوكرانيا، واعتبر إدانتها لاعتراف روسيا باستقلال الجمهوريتين في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا قريبة جدًا من موقف “الناتو” وموقف معظم دول العالم.
وبالتالي هي ليست على الحياد تمامًا، ولكنها تحاول قدر الإمكان تجنب الانخراط المباشر في هذه الأزمة، كما حاولت تركيا عدم الصدام مع روسيا، مثل الامتناع عن التصويت في مجلس أوروبا لتجميد عضوية روسيا.
ويرى الحاج أن روسيا في ظل هذه اللحظة ستسعى إلى تجنيب سوريا أي تداعيات لهذه الأزمة، لكن إذا ذهبت أزمة أوكرانيا أو الحرب إلى محتوى ومرحلة استنزاف روسيا على المدى البعيد، فإن كلًا من الغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى، سيعملان على التصعيد في سوريا، كمحاولة لتضييق الخناق على بعضهما فيها، وفتح جبهة في سوريا.
وعليه لا يعتقد الحاج أن تركيا ستقدم شيئًا لروسيا في سوريا، وإنما هي متخوفة من تحركات معيّنة ربما في الملف السوري، وتريد أن يبقى الوضع القائم على أقل تقدير على حاله في هذه اللحظة.
توتر روسي- إسرائيلي
تربط كلًّا من إسرائيل وموسكو علاقة ودية متبادلة في الفترة التي سبقت “الغزو” الروسي لأوكرانيا، لوجود مصالح للطرفين في سوريا.
ويتخوّف مسؤولون إسرائيليون من أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قد تعطل جهود إسرائيل لدرء النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.
وتحاول إسرائيل تجنب أي تصريحات أو أفعال قد تزعج روسيا، لدرجة أنه طُلب من كبار مسؤولي الدفاع عدم التعليق علنًا على الوضع في أوكرانيا، خوفًا من أن تكون لذلك تداعيات خطيرة على جهود إسرائيل لإبقاء إيران ووكلائها الإقليميين تحت السيطرة، بحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
كما عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن فرض عقوبات أمريكية على روسيا ردًا على غزو محتمل لأوكرانيا، يمكن أن يضر بالمصالح الأمنية لإسرائيل في سوريا.
وفي سياق منفصل، دانت إسرائيل “الغزو” الروسي لأوكرانيا، في 24 من شباط الماضي، ووصفته بأنه “انتهاك خطير للنظام الدولي”.
وأفادت صحيفة “Times Of Israel” أن روسيا استدعت السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، لتوضيح موقف إسرائيل بشأن “غزو” أوكرانيا.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، في 25 من شباط الماضي، عن تقارير عبرية، سأل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السفير الإسرائيلي: “لماذا تدعم إسرائيل النازيين في أوكرانيا؟”.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في “المركز الدولي للجيوبوليتيك” في باريس خطار أبو دياب، أنه ليس هنالك أدلة بشأن وجود توتر إسرائيلي- روسي، حول قضية أوكرانيا، لأن إسرائيل لا يمكن أن تقف أمام أمريكا، ولكنها تبدو في موقف أقرب إلى الحياد، والأقرب حتى إلى روسيا في الموضوع الأوكراني.
ويعتقد أبو دياب أنه بالنسبة لسوريا فإن الاتفاقيات الحاصلة تُحترم بين الطرفين حتى اللحظة، ولا تدل على إمكانية حصول أي صدام بينهما.
وعلى العكس من ذلك، فإذا تم الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، سيحدث تقارب إيراني- أمريكي، وسينعكس ليصبح تقاربًا إسرائيليًا- روسيًا.
واعتبر أبو دياب أن إسرائيل تأكل كل ما هو في الصحن، أي أن لديها استراتيجيتها مع واشنطن، ولكنها أنشات صلة استراتيجية مع بوتين أيضًا، ولذا فهي غير محرجة، بل استفادت من الحرب الأوكرانية في استقبال الآلاف من اليهود الذين فروا من أوكرانيا.
كما أن إسرائيل أنشأت علاقة استراتيجية وتكنولوجية عظيمة مع الصين، ومن ثم مع بوتين، وهذا كله نراه في كثير من المحافل على الأرض.
أين تقف إيران من المعادلة؟
يرى أستاذ العلوم السياسية خطار أبو دياب أن الروس منزعجون من عدم وفاء إيران بتعهدات كانت قطعتها بعدم الاقتراب من الجنوب السوري.
وعندما تقوم إسرائيل بغارة معيّنة، فإن روسيا تعهدت بحماية النظام، فكل ما يهم الروس ألا تقترب إسرائيل من النظام ورأسه.
ولا يعتقد أبو دياب أن هناك خروجًا عن الاتفاق الروسي التكتيكي بين هذه الأطراف.
وإن ما يظهر من دعم إيران لروسيا في قضية “غزو” أوكرانيا، هو موقف الإعلام فقط، ولكن في حقيقية الأمر فإن بلدًا مثل باكستان هو من وقف إلى جانب روسيا.
وإذا بدأ الاتفاق النووي مع أمريكا، فستكون إيران أقرب عمليًا لأمريكا منها إلى روسيا.
وكانت إيران هي القوة البرية لسلاح الجو الروسي في سوريا، ولكن منذ فترة بدأ التباعد في المصالح يظهر على العلن، لأن كل طرف يعمل على تعزيز مواقعه على حساب الطرف الآخر داخل سوريا، وكأنها جزء من أمنه الاستراتيجي وتتمة لنفوذه.
معركة بطون خاوية يخوضها السوريون
من الأوضاع الاقتصادية المتردية مسبقًا والغلاء وانخفاض القدرة الشرائية، إلى سياسة رفع الدعم واقتراب شهر رمضان، ثم الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية عالميًا والمتوقع امتدادها إلى الشرق الأوسط، تتوالى الأزمات الاقتصادية على السوريين في مختلف الجغرافيا السورية على اختلاف الجهة التي تسيطر عليها.
وتدور معظم التوقعات حول ارتفاع معظم أسعار السلع والواردات من القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة المشتقات النفطية التي يواجه السوريون صعوبات في شرائها، بينما يتجهون إلى طرق “سلبية” للتكيف مع تدهور الوضع المعيشي في البلاد، من خلال عمالة الأطفال وزواجهم وبيع الأصول الإنتاجية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
النظام يستبق التداعيات:
تدهور الاقتصاد السوري مرتبط بالتدهور العالمي
ما إن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء ما وصفها بـ”عملية عسكرية خاصة” في إقليم دونباس، في 24 من شباط الماضي، حتى ربط مسؤولو النظام السوري تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا بتبعات الأزمة.
سارعت حكومة النظام إلى عقد اجتماع قالت إنه استجابة للتطورات في أوكرانيا، وأعلنت عقبه قرارات “تقشفية” لإدارة المخزونات المتوفرة من المواد الأساسية خلال الشهرين المقبلين.
خرج بعده وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، وأعلن أن اقتصاد سوريا ليس بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، وأكد أن حكومة النظام تستورد من القمح شهريًا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن، بينما يكلف استيراد النفط سنويًا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو.
ومع فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تعهدت مستشارة رئيس النظام السوري، لونا الشبل، بدعم روسيا في وجه هذه العقوبات كما فعلت موسكو مع دمشق، بينما تطبق حكومتها سياسة رفع الدعم عن المواطنين في مناطق سيطرتها بذريعة عدم القدرة على الاستمرار فيه.
وبدأ السوريون يرون انعكاسات “الغزو” الروسي لأوكرانيا، من خلال القرارات التي اتخذتها حكومة النظام السوري مع بداية الحرب، بشد الحزام وسياسة التقشف وتخفيض النفقات لمواجهة أيام مقبلة، بحسب ما قاله الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والباحث في الاقتصاد فراس شعبو، في حديث إلى عنب بلدي.
وأضاف شعبو أن حكومة النظام منعت تصدير العديد من المواد الغذائية في الفترة المقبلة، كما أوعزت للوزارات في ضبط النفقات بشكل كبير، وهذا مؤشر على أن الأيام المقبلة ستكون صعبة اقتصاديًا على النظام وعلى المواطنين الذين يعانون بشكل مسبق من ارتفاع الأسعار.
ارتفاع الطاقة وانخفاض الدعم الذي يحصل عليه النظام من روسيا بشكل مباشر أوغير مباشر سيلقي بظلاله على تكاليف المعيشة، وسيفاقم المشكلات الاقتصادية، بحسب شعبو، إذ كانت روسيا تسهم بإمداد النظام ببعض القمح والطاقة والتجهيزات.
وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أعلن، في 9 من شباط الماضي، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، ازدياد حجم التبادل التجاري بين روسيا وحكومة النظام ثلاثة أضعاف في عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضح شعبو أن ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة الحرب سيلقي بظلاله على الواقع الاقتصادي السوري، لأن حكومة النظام اعتبرت نفسها طرفًا في هذه الحرب.
صرح رئيس النظام، بشار الأسد، أن سوريا وروسيا يقاتلان العالم و”الحرب كونية”، ووضع نفسه في خندق روسيا، وبالتالي العقوبات التي ستُفرض على روسيا ستفرض أيضًا على النظام السوري، وفقًا للباحث.
وقال شعبو، إن روسيا اليوم تعاني من مشكلات اقتصادية جمّة، ونظام الأسد لم يكن ذا أولوية لها على قدر الأولوية الممنوحة للوضع الداخلي في روسيا، ولذلك سيعاني النظام وهو مدرك لذلك، ويحاول إبقاء الاتصال المباشر مع الإيرانيين خشية التغيير الجذري في المنظومة وتوقف الحرب ورضوخ روسيا للشروط الأوروبية.
وبناء على ذلك، توقع الباحث أن تصل الليرة السورية إلى مستويات قياسية مجددًا، إذ انخفضت هذه الفترة إلى 3900 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، ومرشحة بقوة لأن تصل في الأيام المقبلة إلى 4000 و5000 ليرة للدولار، لأن النظام بالأساس ليست لديه القدرة على ضبطها بالموارد، ولكن يضبطها بالأساليب الأمنية.
وأشار شعبو إلى أن الحالة الاقتصادية العامة وتدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار عالميًا، بالإضافة إلى التضخم الحاصل وسوء الخدمات المقدمة بالداخل السوري وتخفيض الدعم عن جزء كبير من الشعب، وكذلك العقوبات الاقتصادية وتشديد النظام سياسة الإنفاق، ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري ولن تكون لديه القدرة على التكيف السلبي، مؤكدًا التقارير الأممية التي تحدثت عن ذلك.
وبيّن أن المشكلات الاقتصادية التي سيواجهها السوريون من الممكن أن تتحول إلى مشكلة اجتماعية ومشكلة أخلاقية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من التقاريرالاقتصادية قالت إن سوريا متجهة لمجاعة والواقع يوحي بذلك، مع غياب التدخل الحكومي.
شمال شرق.. حرب ترسخ الأزمة الاقتصادية
لا تكاد تبدأ أي أزمة حتى تظهر بوادرها بوضوح في أسواق شمال شرقي سوريا، إذ تتوفر معظم البضائع في المنطقة في الأوقات العادية، لكن هذه الحال تختلف عند إغلاق أي معبر أو أزمة سياسية أو عسكرية، لتختفي تلك البضائع أو ترتفع أسعارها بشكل مفاجئ.
وانعكست تداعيات الأزمة الأوكرانية بعد “الغزو” الروسي على أسعار المحروقات عالميًا بشكل واضح، بسبب فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على روسيا، بينما يتخوّف الأهالي من انخفاض قيمة العملات المتداولة وانقطاع المواد الغذائية الأساسية، منها القمح والشعير، بحسب ما رصدته عنب بلدي من تجار عاملين في المنطقة.
ارتفاع في الأسعار
شهدت أسواق شمال شرقي سوريا أزمات متلاحقة خلال الأعوام الماضية لتأمين الاحتياجات الأساسية، كان أشدها أزمات السكر والخبز وتأمين المحروقات للسكان في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”.
ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية والحديث عن أثرها الاقتصادي المحتمل على سوريا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المنطقة، رغم أن مصدر معظم المواد الموجودة في مناطق سيطرة “الإدارة” العراق أو تركيا أو إيران.
ومن هذه المواد المستوردة، الزيوت النباتية والسمن النباتي وبعض أنواع المعلبات من مصدر أجنبي بنسب تتراوح بين 20 و25% من السعر الأصلي للمادة قبل بدء الحرب في أوكرانيا.
بينما أقر مسؤول في “الإدارة الذاتية” (طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام)، بأن السياسة المالية لـ”الإدارة” وغياب دور فعّال للمؤسسات التابعة لها بالتدخل المباشر في الأسواق، يترك تلك الأسواق عرضة لتصرفات التجار الذين يستغلون الأزمات ويحتكرون المواد ويرفعون أسعارها.
وذكر المسؤول أن “الإدارة” لا تملك أي مخزونات استراتيجية كبيرة للمواد المهمة، ومعظم المواد التي يتم استيرادها هي للاحتياجات اليومية، ولا تكفي لسد أي احتياج مفاجئ في غير الأوقات العادية.
واعتبر أن غياب دور البنوك وعدم وجود مؤسسة نقدية لدى “الإدارة” هو السبب الرئيس للأزمات الاقتصادية، إلى جانب حجم الفساد والبيروقراطية الكبير المتفشي في مؤسسات “الإدارة”، وأن أي أزمة قد تحدث تحتاج إلى كثير من التخطيط والاجتماعات لتتفاقم الأزمة قبل أن تتمكّن “الإدارة” من التدخل أو الحد منها.
مدنيون ينتظرون دورهم للحصول على مادة السكر في منطقة الشدادي بريف الحسكة (نورث برس)
“الإدارة الذاتية” تتجه إلى الاكتفاء الذاتي
الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في “الإدارة الذاتية”، سليمان بارودو، قال في مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، إن المنطقة بشكل عام تتجه نحو أزمة حقيقية، وذلك بسبب أن معظم الدول والحكومات العربية، وليس مناطق شمال شرقي سوريا فقط، تستورد بعض المواد الضرورية من روسيا أو أوكرانيا أو من الاثنتين معًا، خاصة مواد مثل القمح والزيوت النباتية والمعدنية والطحين وغيرها.
وأضاف أنه بعد وقوع الحرب بين الطرفين قفزت أسعار كثير من المواد، وخاصة المحاصيل الزراعية التي شهدت ارتفاعا ملحوظًا، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي وحتى الاستقرار السياسي في المنطقة.
وحول سؤاله عن الخطة التي ستعمل بها “الإدارة الذاتية” للتقليل من التداعيات الاقتصادية وارتفاع المواد، أجاب بارودو أن الخطة هي الاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
وقال بارودو، “من خلال خططنا التي سنعتمدها في المستقبل القريب، كدعمنا لإنشاء المعامل والمصانع من خلال الموارد الأولية المتوفرة لدينا، وخاصة ربط مخرجات العملية الزراعية بمدخلات العملية الصناعية، ودعم المشاريع الزراعية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي”.
بدوره، يرى الباحث في الشؤون الكردية والمقيم في القامشلي شفان إبراهيم، أنه وفقًا لتكلفة الحرب والتضخم في أسعار النفط العالمي وتأثيره على أسعار الشحن، فإن استيراد القمح على سبيل المثال من روسيا أو أوكرانيا إلى مناطق “الإدارة” سيعني المزيد من الأعباء في هذه المنطقة بسبب ارتفاع تكلفته.
وأشار إبراهيم إلى وجود أراضٍ زراعية كثيرة ومساحات شاسعة في مناطق شمال شرقي سوريا، إلا أنه لا يوجد اهتمام بهذه الزراعة، وليس هناك خطط تكفل تطوير الزراعة بما يتناسب مع الاحتياج الشعبي.
فبالدرجة الأولى سيكون هناك تأثير بأسعار الشحن وأسعار السلع الواردة، إضافة إلى قلة القمح الموجود نتيجة الجفاف في العام الحالي وفي السنوات السابقة، وفق إبراهيم.
لا تخطيط استراتيجيًا
عزا إبراهيم أسباب التأثر السريع في الأزمات بمناطق “الإدارة” إلى غياب التخطيط الاستراتيجي الذي دفع بالمنطقة إلى استيراد المواد التي يمكن أن تحقق اكتفاء ذاتيًا.
ولمؤسسة التخطيط الاستراتيجي أهمية كبيرة، حسب إبراهيم، إذ سيكون من شأنها وضع الخطط الكفيلة بالتنمية والزراعة والتجارة والصناعة، وهذا التخطيط سيلزم “الإدارة” بفتح علاقات سياسية مع جوار كل من يمكن له أن يشكّل ضاغطًا أو مانعًا لإمكانية التطوير الاقتصادي في المنطقة.
وطالب الباحث “الإدارة الذاتية” بدعم القطاع الزراعي فورًا عبر إعطاء قروض مالية وتوفير الكهرباء والمازوت، فاستمرار الوضع الدولي بضعة أسابيع أخرى على هذا المنوال سيهدد محصول القمح، وحتى استيراد القمح بكميات يعني ارتفاع سعر ربطة الخبز.
ولم تنتبه “الإدارة” إلى هذه المواضيع منذ البداية، ولم تولِها أي اهتمام، فأسعار البذار والمواد الداخلة إلى “الإدارة” هي بالدولار وبأسعار عالية جدًا.
وأضاف إلى ذلك غياب التيار الكهربائي الذي تسبب بعدم تمكّن المزارعين من زراعة القطن، وهو مورد اقتصادي مهم ويسهم في التصدير والصناعة وتشغيل محلج ومعمل الغزل والنسيج الموجود في الحسكة وتوفير فرص عمل كثيرة وموارد اقتصادية محلية جيدة.
انعكاس سياسي على المنطقة
ولفت الباحث شفان إبراهيم إلى عدم إمكانية الحديث عن أثر اقتصادي دون الحديث عن أثر سياسي، وبالتأكيد فإن تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا سينعكس على المنطقة ليس اقتصاديًا فحسب، بل حتى سياسيًا اليوم مع ازدياد وتيرة التهديدات والعقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا.
وتنتشر قواعد أمريكية في شمال شرقي سوريا، والتي تدعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مع وجود قواعد روسية، واشتداد سعير الحرب في أوكرانيا سيعني اعتماد الروس على تلك الحرب في أكثر من منطقة، ومنها سوريا، حسب الباحث، الذي يرى إمكانية أن تلجأ روسيا إلى ابتزاز هياكل الحكم المحلية أو السلطة في شمال شرقي سوريا بعدم انجرارها إلى أي موقف سياسي أو سيتم التلويح بعصا المناطق التي تحميها روسيا بالشراكة مع “الإدارة الذاتية”، وهي مناطق تحت التهديد التركي بطبيعة الحال.
شمال غرب.. ليس بمنأى عن آثار الغزو
تعتمد مناطق شمال غربي سوريا، التي تسيطر عليها حكومتا أمر واقع هما “الإنقاذ” و”السورية المؤقتة”، في أغلبية اقتصادها على بعض الموارد والمنتجات والبضائع المحلية من المزروعات والمصنوعات المحلية.
وتستورد السلع والبضائع من تركيا عبر المعابر الرسمية، وتتضمن بشكل رئيس مواد غذائية ومواد بناء، ومحروقات وغيرها، كما تمر السلع المستوردة من دول أخرى إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة عبر المعابر مع تركيا.
“الغزو” الروسي لأوكرانيا أثّر على اقتصاد العديد من الدول وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأثّر بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المناطق حاليًا وعلى المدى البعيد، خاصة أن السكان في مناطق الشمال السوري يعانون من سوء وتردي الأحوال المعيشية، ومن الفقر وعدم قدرة العائلات على تأمين قوت يومها ومستلزماتها.
تأثير غير مباشر
الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور يحيى السيد عمر، أوضح لعنب بلدي أن “الغزو” الروسي لأوكرانيا أثّر على الاقتصاد العالمي برمته، ولا توجد دولة بمنأى عن هذا التأثير، وفيما يتعلق بمناطق شمال غربي سوريا، فهي ستتأثر بشكل غير مباشر.
ومن هذه التأثيرات، بحسب السيد عمر، ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كالغاز المنزلي والمحروقات، خاصة أن أغلبيتها مستوردة من الخارج، إضافة إلى احتمال وجود صعوبة في التوريدات في ظل ارتفاع الأسعار.
وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن تتأثر المنطقة سلبًا من خلال ارتفاع نسبة الفقر كنتيجة مباشرة لارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية وتراجع مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة، بحسب الباحث.
“المؤقتة” ستتأثر على المدى الطويل
وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، التي تسيطر على ريف حلب إلى جانب مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة، عبد الحكيم المصري، قال لعنب بلدي، إن وجود حرب أو نزاع بين دولتين تنتجان مواد مهمة ورئيسة كالقمح والغاز سيؤثر على الجميع، وستتأثر أغلب القطاعات بشكل عام لكن بالأخص قطاعات النفط والمحروقات بالإضافة إلى القمح.
ورجح المصري ارتفاع أسعار هذه المواد لارتفاعها في كل مناطق العالم، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وارتفاع أسعار النقل البحري، وبيّن أن هذه المواد ستتوفر ولن تؤثر على مناطق نفوذ “الحكومة المؤقتة”، لكن سيطرأ ارتفاع على أسعارها.
وتأثير “الغزو” لن يكون كبيرًا على مناطق نفوذ “الحكومة المؤقتة”، لوجود مخزون من هذه المواد، لكن في حال استمر “الغزو” سيظهر التأثير، بحسب الوزير المصري.
تأثير مباشر في مناطق “الإنقاذ”
مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، حمدو الجاسم، قال لعنب بلدي، إن “الغزو” الروسي لأوكرانيا له تأثير كبير وانعكاسات “خطيرة” على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من تبعات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وله أثر على مناطق شمال غربي سوريا، التي تعتمد على الاستيراد إذ تقدر نسبة الاستيراد 80%.
الجاسم أوضح أن أي ارتفاع عالمي بأسعار السلع يؤدي إلى ارتفاعها في المناطق الأخرى بشكل مباشر، وخصوصًا الطاقة، إذ تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدّري الغاز والنفط حول العالم، ونتيجة “الغزو” والعقوبات الاقتصادية، ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير، إذ تجاوزت أسعار “خام برنت” (وهو التصنيف التجاري الرئيس للنفط الخام الخفيف الحلو الذي يُستخدم كمعيار رئيس لأسعار شراء النفط عالميًا) 110 دولارات للبرميل.
وبعد الغزو الروسي واصلت أسعار النفط صعودها، واتجه “خام برنت” نحو تسجيل 120 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام، نتيجة عقوبات أمريكية على شركات تكرير روسية، واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى في أعوام.
طحين “الإنقاذ” أوكراني
بالنسبة لمناطق نفوذ “الإنقاذ”، فهي بحسب الجاسم تستورد الطحين من تركيا، التي بدورها تستورده من أوكرانيا، و90% من القمح أو الطحين الذي يدخل مناطق نفوذ “الإنقاذ” هو أوكراني.
الجاسم بيّن أن سعر القمح في مناطق سيطرة “الإنقاذ” ارتفع من 370 دولارًا للطن الواحد إلى 400 دولار، خلال الأيام الأولى من “الغزو”، ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات 460 دولارًا للطن.
ويعاني سكان شمال غربي سوريا من ارتفاع أسعار السلع والمواد الذي شهدته الأسواق في المنطقة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يحول دون تأمينهم حاجاتهم من المواد الرئيسة والثانوية.
ولا يقتصر الأمر على السلع والمواد الغذائية، إذ وصل الغلاء إلى مادة الخبز الأساسية، التي رصدت عنب بلدي صعوبة تأمين الناس حاجتهم منها، إذ لجأ الناس إلى خبز التنور الأقل ثمنًا من خبز الأفران.
جهود حسب الإمكانيات
الجاسم توقّع أن يصل الإنتاج المحلي للقمح إلى حوالي 80 ألف طن للعام الحالي، وتحقيق أكثر من 60% من الأمن الغذائي لتخفيف المعاناة عن الأهالي في مناطق نفوذ “الإنقاذ”.
وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية، فإن حكومة “الإنقاذ” ستضخ من مخزونها الاستراتيجي، بحسب الجاسم، لتغطية الفعاليات في مناطق سيطرتها من أفران ومحطات مياه ومستشفيات ومشاريع اقتصادية إنتاجية.
ويعاني الشمال السوري من سوء وتردي الأحوال المعيشية، ومن الفقر وعدم قدرة العائلات على تأمين قوت يومها ومستلزماتها، وأظهر استبيان أجراه “برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية” (HNAP)، بالاشتراك مع “الأمم المتحدة للتنمية”، ومجموعة التعافي المبكر وسبل العيش في شمال غربي سوريا، “الحرمان الاقتصادي” الذي يعيشه الناس في سوريا، بحسب تقرير صدر في 14 من أيلول 2021.
عنب بلدي
————————————
شبيحة النظام السوري وزيلينسكي/ رشا عمران
البحث عن صاحب ضمير وموقف إنساني لدى شبيحة النظام السوري هو كالبحث فعلا عن إبرة وسط كومة القش، سوف تقضي وقتا طويلا تبحث في كومة القش عما يلمع كي تحمد الله أنك وجدت الإبرة المفقودة أخيرا، ستفعل الشيء ذاته وأنت تنتقل من صفحة إلى أخرى ومن حساب إلكتروني إلى آخر لو خطر لك أن تطلع على ما يكتبه شبيحة النظام السوري عن الحدث الروسي الأوكراني الراهن، ونحن نتكلم هنا عن الطبقة المتعلمة والمثقفة وعن نخب ثقافية وعلمية وفكرية لا عن عامة وغوغاء قطيعي، هنا أيضا سوف تقضي وقتا طويلا وأنت تبحث عن موقف إنساني مغاير، عن صوت ما من أصواتهم يقول مثلا إن الحرب كارثية وإن المدنيين يدفعون أثمانا باهظة لما يريده جنرالات الحروب، وإن الحرب ليست سوى مزيد من الحزن والخوف والقهر والتشرد والجوع والموت، وإن ما يحدث في منطقة من العالم لا يقف عندها، أثره سوف ينتقل بحكم ارتباط المصالح السياسية والاقتصادية وتشابكها، لكنك مهما بحثت لن تجد سوى تمجيد الحرب وتمجيد بوتين، قيصر الموت، والشماتة بالأوكرانيين المعتدى عليهم دون أن تجد سببا يبرر الشماتة الطافية غير سبب وحيد: من استمرأ العيش خاضعا ومذلولا سوف يتمنى الخضوع والذل للجميع كي لا يشعر بالعار، فالتشارك مع الآخرين في هوية الذل ستخفف عنه إحساسه بالذنب تجاه نفسه، ما يجعل منه حاقدا على من يرفض هذه الهوية وشامتا إذا ما تعرض الرافض لمحاولة الإخضاع.
ثمة خطوط عريضة يشترك في الحديث عنها غالبية الشبيحة السوريين المؤيدين لبوتين في حربه على أوكرانيا، يمكن هنا أن نعددها ضمن عدة عناوين:
يستخدمون جميعهم وسم (تصحيح التاريخ) الجملة التي قالها رئيس النظام السوري في رسالة تأييده لبوتين(وهي واحدة من ثلاث رسائل تأييد دولية فقط وصلت لبوتين)، باعتبارها جملة عبقرية طبعا وباعتبار قائلها الذي يؤيد بوتين في خطوته لإعادة ضم الأراضي التي كانت خاضعة لحكم القيصر إلى حكمه، لم يصدر أمرا بإلغاء إقليم لواء إسكندرون من الخريطة السورية، ولم يضع ختمه على التنازل عن هضبة الجولان مقابل البقاء في حكمه، ولم يبع ويؤجر سوريا وأراضيها واقتصادها لإيران وروسيا.
يمتلكون جميعا نفس الخطاب القديم في الحديث عن الإمبريالية والرأسمالية باعتبار أوكرانيا (ربيبة) الرأسمالية الغربية، مقسمين العالم إلى محور شرير (أميركا والاتحاد الأوروبي وكل من يرغب بالانضمام إليه)، ومحور طيب (روسيا وإيران والصين)، متجاهلين كل التغيرات التي طرأت على سياسة المحاور منذ سقوط جدار برلين وحل الاتحاد السوفييتي، وتحول العالم كله إلى شركة رأسمالية يتصارع مديروها على مصالح متشابهة، وأن المحورين أعاد تعريفهما جورج بوش الابن إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر حينما وضع محور العالم مقابل محور الإرهاب، وكل ما حدث في العالم تاليا هو تطبيق عملي لنظرية محوري بوش.
يكتبون تنظيرات عن الاقتصاد الأوروبي المنهار، وعن دور الحكومات الأوروبية في هذا الانهيار ويبشرون بالمزيد منه بعد انتصار بوتين، مطالبين الأوروبيين (السذج) بالاحتجاج على سياسات حكوماتهم ومبدين استغرابهم من صمت الشعوب الأوروبية الطويل على سياسات التجويع والتفقير الناجمة عن الرأسمالية، وليست مفاجأة أن بعض هؤلاء الشبيحة يحمل جنسيات أوروبية ويعيش في بلاد أوروبية، يا للهول كيف يحتمل هؤلاء الحياة في جحيم الدول الأوروبية الاقتصادي، تاركين الجنة السورية ونعيمها للروس والإيرانيين والأفغان.. الخ.
لا يزال (البوط) العسكري نقطة مشتركة بينهم، فبعد (بوط) الجيش السوري الذي سيقضي على الإرهابيين حان الآن بوط الجيش الروسي الذي سيقضي على الإمبرياليين، المبدأ نفسه أما التفصيل فهو في فرق ترتيب الأحرف في كلمتي (سوريا وروسيا).
يسخرون من الظهور اليومي للرئيس الأوكراني زيلينسكي متحدثا إلى شعبه وإلى العالم عن الغزو والقصف الروسي وآليات مجابهته من قبل الجيش والشعب الأوكراني، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه الطائرات الإسرائيلية إحدى طلعاتها الروتينية في سماء سوريا مستهدفة موقعا عسكريا إيرانيا أو سوريا بينما يحتفظ بشار الأسد بحق الرد إلى أجل غير مسمى، طبعا اختفت إسرائيل تماما من كتابات هؤلاء الشبيحة، ولكن إن عرف السبب بطل العجب، فالعدوان المتحاربان حاليا (روسيا وأوكرانيا) حليفان قويان لإسرائيل، وإسرائيل يفترض أنها عدوة للنظام السوري المحمي من قبل روسيا، لن يكون القول: (حليف صديقي عدوي وحليف عدو صديقي عدوي) مجديا أو صحيحا، الأفضل هو تجاهل الأمر تماما وكأن إسرائيل غير موجودة حاليا خصوصا أن السوريين معتادون على محي دول عديدة من الخريطةـ للسياسة السورية سوابق معلنة في هذا السياق.
يتجاهلون تحالف رئيس الشيشان (الإسلامي الأصولي) قديروف مع بوتين، وتجنيد مرتزقة شيشان للقتال إلى جانب الروس، وإلى جانب مرتزقة سوريين يشحنون حاليا إلى روسيا للمشاركة في الحرب، ويتجاهلون أيضا تحالف بعض الإسلاميين السوريين ومنهم معارضون لبشار الأسد مع قديروف وبوتين.
يشمتون باللاجئين السوريين من أبناء شعبهم وهم يعرضون صور استقبال العالم للاجئين الأوكران بينما يغلق حدوده أمام السوريين، ولا يتذكرون أن في 2012 و2013 كان وضع السوريين اللاجئين إلى دول الجوار مشابها لوضع الأوكرانيين تماما، حيث فتحت دول الجوار والعرب حدودها لمئات آلاف السوريين الهاربين، طبعا لا يتساءل هؤلاء الشبيحة عن سبب هروب السوريين وتخليهم عن كل شيء للنجاة بحياتهم، مثلما لا يخطر لهم السؤال عن سبب هروب الأوكرانيين من وطنهم وبيوتهم مادام الأمر تصحيحا التاريخ كما يقولون عن الغزو! ألا يعتقدون أن الأوكرانيين يفضلون التشرد على الخضوع للقيصر الروسي الحديث؟
مجددا يسخرون من زيلينسكي واصفين إياه بالمهرج في إشارة إلى مهنته الأولى (ممثل) وهو الذي يتصرف بوصفه واحدا من الشعب ويقضي جل وقته في مراسلة ومخاطبة زعماء العالم والرأي العام العالمي عبر كل وسائط الاتصال لحشد دعم دولي ضد روسيا دون أن يتلكأ لحظة واحدة، بينما (حكيم عيون وفهيم بالعين) لا يتجرأ على النظر إلى السماء لمعرفة عدد الطائرات الإسرائيلية التي تسرح وتمرح يوميا في سماء سوريا.
قديما قالوا إذا لم تستح فافعل ما شئت، والحقيقة أن شبيحة النظام السوري من النخبة المثقفة لا يستحون فيما يكتبون وينظرون، ولا يخجلون من دموع ضحايا الحروب، لا يخطر لهم وهم يمجدون الحرب ويهللون لها أن مئات آلاف الأمهات في سوريا فقدن أبناءهن في الحرب، ومئات آلاف الأطفال تيتموا في الحرب، وعشرات آلاف النساء ترملن في الحرب، وأن هؤلاء أمهات وزوجات وأطفال الضحايا الذين قاتلوا دفاعا عن بشار الأسد، في الجيش أو في الأمن أو في التنظيمات الأخرى، لكن من كانت هويته هي العار فلن يخجل مما يقول أو يكتب.
تلفزيون سوريا
—————————-
هل استنسخت روسيا «التجربة السورية» في حربها على أوكرانيا؟
تتزايد التحليلات، وخصوصاً في وسائل الإعلام الغربية، حول آليات تعامل القوات الروسية مع الواقع الأوكراني، وأدوات الحرب المستخدمة لتحقيق الأهداف الموضوعة للعملية العسكرية. وذهب عدد من المعلقين والخبراء إلى عقد مقارنات بين الحرب الأوكرانية والحرب التي شهدتها روسيا في الشيشان مثلاً، في وقت مبكر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وخصوصاً لجهة محاصرة المدن وقصفها واستخدام آليات واسعة لإجبارها على الخضوع، حتى أن بعض السياسيين الغربيين والمعلقين العسكريين رأوا أن خاركوف الأوكرانية تكرر حالياً مسار تطور الأحداث في غروزني الشيشانية، في تسعينات القرن الماضي.
روسيا الجديدة
لكن روسيا تغيرت كثيراً على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتبدلت قدراتها العسكرية بشكل جذري، كما تبدلت آليات تعاملها مع الأزمات المحيطة. وللمقارنة، يكفي القول إن الفارق في الوضع الراهن يبدو كبيراً جدا بالمقارنة مع قدرات روسيا العسكرية التي ظهرت عام 1995 في الشيشان، ثم في 2008 في جورجيا. صحيح أن روسيا نجحت في حرب الأيام الخمسة في جورجيا في تحقيق نصر سريع، لكن هذا كان سببه الرئيسي طبيعة «العدو» الذي واجهته، والذي كان ضعيفاً بشكل ملحوظ وغير قادر على خوض معركة حربية.
في أوكرانيا الوضع مختلف تماماً، والخطط العسكرية كذلك مختلفة لجهة الأهداف الموضوعة وآليات التحرك لتنفيذها. هنا، ليس المطلوب تحقيق هدف تكتيكي صغير مثل «إجبار أوكرانيا على السلام» وفقاً للتسمية التي حملتها العملية العسكرية ضد جورجيا في 2008، التي انتهت بسيطرة سريعة على العاصمة تبليسي، قبل الانسحاب بوساطة أوروبية وفرض استقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وإقفال ملف الصراع مع جورجيا إلى أجل غير مسمى.
فالأهداف الموضوعة في أوكرانيا أبعد وأكثر تأثيراً، ولها أبعاد تتجاوز حدود الدولة الأوكرانية، لترتبط أكثر بهندسة الأمن الأوروبي عموماً، وبدور ومكانة روسيا في منظومة العلاقات الدولية الجديدة.
كما أن أوكرانيا الشاسعة المساحة، وبقدراتها العسكرية الضخمة نسبياً، وبحجم المساعدات الغربية التي تدفقت عليها، لا تشكل هدفاً سهلاً للروس، وهو ما أظهره حجم «المقاومة الشرسة» في المدن الكبرى ومعدلات الخسائر غير المسبوقة التي تكبدتها روسيا حتى الآن.
من هذه الزاوية، ومع فهم أن موسكو تواجه عملياً تحالفاً في أوكرانيا، وتعقيدات مرتبطة بتدخل أطراف خارجية كثيرة في هذا الصراع، بدا استنساخ التجربة السورية في الحرب الأوكرانية أمرا مفيداً ومهماً.
فهذه الحرب هي الأولى التي تخوضها روسيا بعد «الاختبار السوري»، الذي ساعد موسكو كثيراً في تطوير قدراتها من خلال «التدريب» في ظروف حرب حقيقية، فضلاً عن أن موسكو نجحت خلال سنوات تجربتها السورية في تطوير تقنياتها العسكرية بشكل غير مسبوق، ما جعلها تضع برامج واسعة لتعديل اتجاه الصناعات العسكرية وتحديث إنتاجها الحربي بناء على دروس الحرب.
لذلك، كان من الطبيعي أن تنعكس «التجربة السورية» في ميادين القتال في أوكرانيا، وهذا ما اتضح من خلال جملة من العناصر العسكرية والسياسية المرتبطة بتقدم العمليات في هذا البلد.
السلاح المجرب
بدايةً، يمكن التوقف عند استخدام طرازات من الأسلحة الحديثة التي خاضت التجارب في سوريا، مثل المروحية الضاربة «صياد الليل» التي تم تطويرها بشكل كبير بعد مشاركة فاعلة لها في مواجهات تدمر وحلب ومناطق أخرى. هذه المروحية تلعب حالياً أدواراً مهمة في مهاجمة المواقع والمنشآت الأوكرانية في ساعات الليل.
أيضاً، كان ملاحظاً استخدام الضربات الصاروخية الموجهة نحو المواقع التي فشلت روسيا في الوصول إليها والسيطرة المباشرة عليها، كما حدث مع مطار عسكري في وسط أوكرانيا، تم تدميره كلياً قبل يومين بصاروخ موجه يمتلك قدرات تفجيرية هائلة، كان خضع للتجارب في سوريا.
ومع القدرات الهجومية، بدا أن تكتيك توزيع العمليات مستعار أيضاً من الحرب السورية، لجهة آلية تقسيم المناطق والأهداف، والاعتماد على «الحلفاء» في خوض معارك برية لتوسيع مساحات السيطرة الميدانية في بعض المناطق في الجنوب والشرق، في مقابل تقدم الجيش باتجاه محاصرة المدن الكبرى.
أيضاً، كان لافتاً استخدام آليات الحرب الإعلامية نفسها التي جربت طويلاً في سوريا، مثل التنبيهات المتكررة من وزارة الدفاع بأن «النازيين يجهزون لاستفزاز عبر استخدام مواد تفجيرية محظورة»، بهدف إلقاء اللوم على الجيش الروسي، أو «سعي أوكرانيا لتطوير قنبلة نووية قذرة» لاستخدامها ضد مواقع مدنية بهدف اتهام الروس بارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن اتهامات بقيام الأوكرانيين بقصف وتفجير منشآت أو مواقع مدنية، وغير ذلك من آليات الحرب الإعلامية التي استخدمت بعبارات مماثلة في سوريا، لكن بدلاً من السلاح النووي تم في سوريا الحديث عن «الكيماوي»، وبدلاً من «النازيين» كان المخططون في سوريا هم «الخوذ البيضاء» و«الإرهابيون».
وثمة عنصر آخر للمقارنة لا يمكن أن يغيب عن المشهد، وهو يتعلق بآليات المفاوضات الجارية بين الروس والأوكرانيين، إذ تحولت جولات التفاوض إلى مناقشة مشكلات «إنسانية»، تتمثل في المعابر الآمنة والممرات الإنسانية، والهدف، كما كان حصل في سوريا مراراً، تسهيل عملية خروج المدنيين والمقاتلين من التجمعات السكانية الكبرى، لتيسير السيطرة عليها لاحقاً.
والغريب أن جولات التفاوض التي جرت على الأراضي البيلاروسية لم تناقش البعد السياسي أو آليات لوقف النار والانتقال إلى تسوية سياسية، رغم أن مستوى التمثيل فيها، خلافاً مثلاً للوضع حول «مفاوضات أستانة»، يسمح بذلك، لجهة وجود ممثلين عن الديوان الرئاسي في أوكرانيا وروسيا وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين.
وجاء أخيرا الإعلان المتكرر على ألسنة المسؤولين الروس حول «توافر معطيات عن وجود مسلحين قاتلوا في سوريا على الأرض الأوكرانية»، ليضع عنصراً جديداً في هذه المقارنة، رغم أنه لم يثبت وجود أي مقاتل أجنبي حتى الآن في أوكرانيا، فضلاً عن نفي جهات سورية، بينها المكون الكردي، صحة هذه التقارير.
———————-
عودة البربرية/ بسام يوسف
بالتأكيد ليس لبوتين ما يبرر له غزوه لدولة ذات سيادة، مع ما يعنيه هذا الغزو من تعريض حياة ملايين البشر فيها للموت، وتعريض مدنها للتدمير، والأخطر من هذا، هو استعادة البربرية كأداة أساسية في العلاقة ما بين الدول والشعوب.
لكن إذا أردنا أن نخضع المسألة لعقل بارد، يغيب عنه البعد الإنساني والأخلاقي لهذا الغزو، وتحضر فيه المصالح الجيوسياسية، التي لا تزال ترسم مصير العالم بعد حربين عالميتين ذهب ضحيتهما ما يقرب من خمسين مليون إنسان، فإننا سنجد أنفسنا أمام تساؤلات عديدة.
أول هذه التساؤلات يكمن في الهدف الذي سعت وتسعى إليه أميركا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والمتمثّل بابتلاع كل الفراغ الذي نجم عن هذا الانهيار، ليس بالمعنى الاقتصادي فحسب، بل بتمدد القوة، والحصار، وإلحاق الدول التي تشظت عنه بها، وهو ما يتعارض أولاً مع الضمانات التي وافقت أميركا عليها، ويتجاهل ثانياً القلق الروسي الذي تحاول روسيا التنبيه له منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً وقالته مراراً لأميركا، ولحلفاء أميركا.
ثاني هذه التساؤلات يذهب إلى ما يتم طرحه من جهات متعددة، وهو هل تعمّدت أميركا فعلاً إدخال روسيا في الفخ الأوكراني، متجاهلة عن عمد (تتشارك معها روسيا في هذا التجاهل) مصير ملايين المواطنين الأوكران، ومصير وطنهم ومدنهم وممتلكاتهم، ومتجاهلة أيضاً حياة عشرات وربما مئات آلاف الجنود الروس والأوكران الذين يزج بهم في هذه المحرقة، وهل تتعمد استنزاف روسيا في معركة طويلة لن تستطيع تحمل تكاليفها الباهظة؟ سيما وأن روسيا رغم كل قوتها العسكرية لاتزال بلداً ضعيفاً، وهشاً في نواح أخرى عديدة، فهي بلد يحتل المرتبة الحادية عشرة في سلم الاقتصادات الأقوى في العالم، وهي بلد ينخر فيه الفساد والمافيات، والأخطر أنها بلد محكوم بالقمع، وأجهزة المخابرات وغياب الحريات.
ثالث هذه التساؤلات هو: ألم يكن أمام بوتين خيارات أخرى للوقوف في وجه التهديدات التي يتحجج بها؟ ولماذا اختار أكثرها كلفة، وأكثرها احتمالا لخسارة إن تحققت فقد يترتب عليها إعادة روسيا عقودا إلى الوراء، وربما تفكيكها أيضاً، والأهم أنه مهما تكن نتائجها فإنها ستفرض مناخاً عالمياً سيعيد البشرية إلى أجواء سباق التسلح، وعودة الاستقطاب العالمي، وسوف يؤدي هذا السباق الدامي على النفوذ الجيوسياسي إلى إيقاظ وخلق بؤر توتر عالمية جديدة، تضع العالم كله على حافة حرب مدمّرة، يُمكن أن تنفجر بأي لحظة.
من الخطأ الركون إلى ما يطفو على السطح من تحالفات ظاهرة، فاللحمة التي أبدتها دول أوروبا أمام الحدث الأوكراني قد تبدأ بالتفسخ حين تتعقد ظروف الحرب وتتباين المصالح، ولنا في قراءة الحربين العالميتين الأولى والثانية دلائل كثيرة على تغير خارطة التحالفات بين الدول الأوروبية، ومن الخطأ أيضا الركون إلى الحائط الصيني الذي تسند روسيا ظهرها إليه، فالصين أيضا ترى في عزلة وإضعاف الجار الروسي مكسبا استراتيجيا لها، والتحالف الأميركي الأوروبي أيضاً فيه ما فيه من تناقضات ظهرت إلى العلن مراراً في السنوات السابقة.
يبدو أن بوتين اختار جرَّ العالم إلى المواجهة العسكرية، لأنه بذلك يذهب إلى عنصر القوة الوحيد الذي يملكه، ويتفوق فيه، وهذا ما تحاول أميركا تفويته على الروس عبر حصر المعركة العسكرية في أوكرانيا واستنزاف الروس فيها، وتأجيج المواجهة الاقتصادية التي لن يستطيع الروس مجابهتها، أو إحراز أي نصر فيها، لكن السؤال هنا: هل تضمن أميركا أن ينجرَّ الروس إلى تحييد سلاحهم الأهم، وأن يغيروا حقل الصراع ليذهبوا إلى الحقل الذي اختارته أميركا؟
بعيداً عن الصراع الدائر في هذه اللحظة بوجهيه العسكري والاقتصادي، فإن السؤال الذي لا يمكن تغييبه، وليس بالإمكان تجاهل تداعياته اللاحقة في هذه الحرب كما في كل الحروب التي عرفتها البشرية، وهو ماذا تورث الحروب للشعوب التي تدفع تكلفتها، وتكون دائما الخاسر فيها، حتى لو كتب لها التاريخ أنها انتصرت؟ فالشعوب تنظر إلى مستقبلها ما بعد الحرب، سواء أكانت مهزومة أو منتصرة.
بعبارة أخرى: ما هو نموذج المستقبل الذي يقدمه بوتين لشعوب الأرض؟ وهل نموذج الدولة الروسية الحالية هو حلم الشعب الروسي أولاً قبل أن يكون حلم غيره؟
يُمكننا تلمّس الإجابة في حركة لجوء المواطنين الأوكران، بمن فيهم الروس الذين يعيشون في أوكرانيا، ويمكننا تلمّس الإجابة أيضاً في الطريقة التي قمعت بها أجهزة الأمن الروسية مواطنيها الروس، الذين تظاهروا ضد الحرب.
قد تفرض روسيا شروطها في أوكرانيا، وقد توافق أميركا على هذه الشروط، ليس لعجزها عسكرياً، وقد يستعيد العالم مشهد تقسيم ألمانيا مرة أخرى بصيغة أوكرانية، لكن هذا لن يكون بوابة لعالم مستقر، إنه ببساطة بوابة لمرحلة يتصدر فيها السلاح قائمة المبيعات في العالم، ولمرحلة تنتعش فيها أشكال الحكم اللاديموقراطية، ومرحلة لاستعادة البربرية في العصر الحديث.
إذا كان النظام العالمي الذي تقوده أميركا بشعاً إلى حد كبير، ويتعمد خلق الكوارث والحروب كلما اشتدّت أزمته الاقتصادية، فإن الطريقة التي حاول فيها بوتين أن يكون جزءاً مهماً من هذا النظام، تفوقت في بشاعتها، وذهبت إلى الصيغة التي تحاول شعوب الأرض كلّها أن تطويها من تاريخها.
لن تكون روسيا رابحة في هذا الصراع، حتى لو احتلت أوكرانيا بالكامل، فالنموذج الاستبدادي الروسي لا يغري أحداً لقبوله، لكن المحزن أن ترغم الشعوب مرة أخرى على العودة إلى الوراء، لتخسر مكاسب عديدة حققتها بعد مآسي حروب لا عدَّ لها، وأن ترغم مرة أخرى على دفع حياة الملايين من أبنائها، وأن تدفع من حاجاتها ومستوى معيشتها أموالا هائلة، محاولة من جديد أن تصل إلى عالم أكثر أمناً وأكثر عدالة.
من بوتين إلى بشار الأسد، إلى رمضان قاديروف، إلى كيم جونغ أون، إلى ألكسندر لوكاشينكو.. إلى … إلى…، وجوه متعددة لحقيقة واحدة ترتكز في فهمها للسياسة وللدولة على تغييب الشعوب وقمعها، لكن الأكثر فجاعة من كل الكوارث التي تلحقها هذه الوجوه بشعوبها وأوطانها، هي أنها العامل الأهم في بقاء الرأسمالية المتوحشة، وفي تعزيز قدرتها على نهب العالم.
تلفزيون سوريا
—————————–
بعد سوريا.. “تهوية” أوكرانيا/ إبراهيم الجبين
”تهوية سوريا“، ربما لم يقل كبار منظري بنوك التفكير والمراكز البحثية خلال السنوات العشر الماضية من عمر المأساة السورية ذلك بحرفيته، إلا أن الذين أشاروا إلى ما يشبه هذا التعبير في الساحة من اليمينيين الأوروبيين كانوا يعنون به بعثرة التكتلات السكانية ذات الطابع القومي والمذهبي الواحد والمتكدّسة طويلاً في مكان واحد، وكان هذا المكان حينئذ سوريا.
اعتبر هؤلاء أن الزمن تطاول على هذا البلد فتزايد عدد السكان العرب المسلمين السنة فيه بصورة غير متناسبة مع نموّ الأقليات العرقية والطائفية الأخرى، وأن الصبر على ذلك لن يفلح في تصحيح الأوضاع، فكان الحل استثمار الحدث السوري المتفجر لتحقيق نوع من ”التهوية“ تتفكك فيها الوحدات الكبرى وتتبعثر في أماكن عديدة، ما سيسمح بخلق التوازن المطلوب.
فابريس بلانش الأستاذ المشارك ومدير الأبحاث في جامعة ليون يرى أن الصدام بين مكونات المجتمع السوري الذي عكف على دراسته منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي أمرٌ حتميٌّ سيحدث الآن أو غداً، ويضيف بلانش أن “هناك خصوصية سوريّة تتجسد في التزايد السكاني السريع، والذي يختلف بحسب الطوائف؛ لأن العلويين والدروز والمسيحيين، لم يعودوا ينجبون أكثر من طفلين للمرأة الواحدة، في حين أنّ المعدّل مرتفع لدى العرب السنة، إلى درجة أنه خلال جيل واحد تراجعت نسبة الأقليات الدينية التي هي ركائز النظام، من 30 في المئة إلى 20 في المئة من سكان سوريا“. ووفقاً لبلانش “بالمنطق السياسي، فإنه يتعيَّن تقليص الثقل السكاني للطبقة والطائفة الخطيرة بالنسبة للنظام وهذا هو سبب دَفعِ ملايين السوريين نحو الخارج”.
تجريف هائل تعرضت له بلدان المشرق العربي، بدءاً من العراق وعلى مدى سنوات طويلة سبقت حتى الغزو الأميركي عام 2003، قبل أن تلتحق به سوريا وبصورة مضخّمة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل، بتهجير السكان من جهة، وباستقبالهم بترحاب من جهة أخرى، فبدا الأمر مزدوجَ الأغراض، أولاً يثبت وحشية الأنظمة والأحداث التي دفعت هؤلاء إلى المغادرة واستحالة الحياة في ظلها، وثانياً يُحدث التغيير المطلوب في المناطق التي سيصل إليها المهجّرون.
ويبدو أن النسخة الأميركية الأصلية من العولمة لم تستكمَل بعد، فكثير من المجتمعات ما يزال عصياً على تقبّل جملة القيم والمفاهيم والعلاقات التي تعبّر عنها العولمة، فالتراصّ السكاني يمنع حدوث مثل هذه التغييرات ويعرقل تسللها، في الوقت الذي تأتي فيه محمولة عبر اللغة التكنولوجية الجديدة والهواتف الذكية والخطاب الفائق الذي لم يعد بوسع أحد إغلاقه مثل جهاز راديو.
السيل المتدفق يتطلب مزيدا من الإجراءات للتمهيد للسوق الحرة، والأخيرة بقواها الناعمة تعجز عن تذليل الطرق، من دون مساندة القوى الأكثر شراسة، حدث هذا في المشرق ويحدث اليوم في قلب أوروبا، والهدف تغيير القارة العجوز جذرياً هذه المرّة.
التزايد السكاني غير المسيطر عليه بالوسائل الحضارية التنموية يخلق واقعاً يتكرّر كل مرة، فالمجتمعات التي تعدّ مناسبة لتعشّش فيها قيم العولمة، لا تتوافر على شهية للتزايد بقدر ما تفعل تلك المجتمعات التي ترفض تلك القيم وما تزال تتمسك بنوع من ”الأصولية“ ذات الأبعاد المتعددة (ليس بالضرورة أن تكون أصولية دينية، اجتماعية، تراثية، تقاليد، أزياء، أمزجة إلخ).
ردود الفعل العنصرية التي برزت خلال الأيام الماضية حيال رؤية لاجئين منكوبين زرق العيون قادمين من أوكرانيا لا يشبهون أولئك السمر الذين اعتادتهم الشاشات الأوروبية، كما ردّد بعض المؤثرين والمسؤولين الأوروبيين، كانت تعبيراً عن الصدمة الأولى، لكنها سرعان ما ستزول ويحلّ محلّها شعور جديد، هو ما الذي سيفعله أولئك الأوكرانيون في أوروبا وهم القادمون من بلاد تعرّضت لغزو روسي وحشي يقودهم رئيس يهودي شاب ليبرالي التوجه؟
السؤال الآخر يتعلق بأوكرانيا ذاتها التي ستجد نفسها وهي تتعرض لهزّة عنيفة أبعد من الغزو ذاته، فما حدث خلال الأيام القليلة الماضية تغييرٌ كبيرٌ يتجاوز الدعم العسكري والسياسي والإنساني، بل يضع المسألة في قلب اهتمام العالم، بقدر ما يصنّع صورة بوتين الجديدة المعزولة، وينقله من موقع القطب الدولي إلى موقع النظام المارق في العالم، مثله مثل خامنئي وكيم جونغ أون وبشار الأسد. بل أكثر من ذلك بدأت تعلو أصوات جادة تتحدث عن معنى وجود روسيا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وجاء هذا على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد أن همست به أوساط لندن عندما قال الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي إثر غزوها لأوكرانيا.
عام 1987 قدمت اليونيسف تقارير تتحدث عن بلوغ معدل النمو السكاني في ليبيـا على سبيل المثال 1,4 وفي المغرب 4,2 في المئة، مقابل 3,1 في المئة بالجزائر ليصل إلى 2,4 في المئة بتونس، وهي معدلات مرتفعة جداً إذا ما قورنت ببعض الدول الغربية التي بلغت مرحلة متقدمة في تحولها الديموغرافي والذي يوصف بتعجرف من قبل الديمغرافيين بمرحلة ”النضج الديموغرافي“. لكن المشكلة تكمن في أوروبا دوماً، في ألمانيا مثلاً بلغ النمو السكاني معدلاً مرعباً حين أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد المواليد الجدد عام 2020 تراوح بين 755 ألفاً و775 ألفاً، في حين جاء عدد المتوفين بما لا يقل عن 980 ألف شخص. وسرّ ذلك ما أطلق عليه المكتب ذاته اسم ”عجز المواليد“ وقدرت نسبته بما لا يقل عن 205 آلاف مواطن.
لنراقب الآتي؛ الولايات المتحدة تشهد نمواً سكانياً، ليس سببه المواليد الجدد، وإنما المهاجرون الجدد، وهي حالة كانت تكاد تكون مغلقة الأبواب في أوروبا، والأمر ذاته في البلدان ”ذات التاريخ الإرهابي“ بحسب وصف مسؤول بلغاري بارز الأسبوع الماضي، وكان يقصدنا نحن مواطني بلدان العالم العربي بالطبع. تلك البلدان التي ما زال السكان فيها يعتمدون الزراعة وسيلةَ إنتاجٍ كبرى للدخل القومي، في حين لا يترافق ذلك مع برامج تنموية كافية، ولا حتى في حدّها بالأدنى، فالتنمية لا تمشي بالتوازي مع الاستبداد والتشبث بالسلطة، ولا ضرورة للتذكير بالمبدأ المفضّل لدى الأنظمة الشمولية التي تدوّن على جدران مسؤوليها ما يشبه الآية المقدّسة ”حين تتحسن أوضاع الإنسان المعيشية سيبدأ بالتفكير في العمل السياسي ويطالب بالمشاركة في السلطة واتخاذ القرار“.
يشكل الأوكرانيون 72,8 في المئة من مواطني أوكرانيا، في حين لا يشكل الروس أكثر من 22.1 في المئة من مجموع السكان، يضاف إليهم أقلية بيلاروسية نسبتها 0,9 في المئة ومولدافية تشكل 0,6 في المئة وبولندية تصل إلى 0,5 في المئة إضافة إلى البلغار ونسبتهم 0,5 في المئة علاوة على العديد من المواطنين الرومان واليونان والتتر. ويصل المعدل الوسطي للزيادة الطبيعية للسكان إلى أقل من واحد بالألف، ويعود سبب ذلك أيضاً إلى انخفاض نسبة المواليد في أوكرانيا، مع انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة المعمرين.
المجتمع الزراعي الذي بدأ بالتآكل، وسوريا نموذج أساسي له في المشرق، وأوكرانيا نموذج ساطع له في أوروبا، يعتمد بالدرجة الأولى على تماسك الأسرة، ما يعني أن تفكيك أحد هذين العاملين سيقود إلى تفكيك الآخر بالضرورة. نعود إلى اليونسكو التي تقول إن العالم الثالث عرف نموا ديمغرافيا لا مثيل له في تاريخ الإنسانية، ونسباً لم تعرفها حتى أوروبا خلال فترة نموها الديمغرافي الكبير إبّان القرن التاسع عشر، إذ إن الزيادة الطبيعية في أوروبا الغربية خلال هذه الفترة كانت في حدود 1 في المئة سنوياً، في حين أن الزيادة الطبيعية التي عرفتها البلدان “المتخلفة” كانت من 2 إلى 3 في المئة سنويا.
مع نهاية العام الماضي توقعت وزارة الزراعة السورية أن يصل إنتاج سوريا من القمح إلى مليون و200 ألف طن، والبلاد تستهلك حالياً 2,5 مليون طن كل عام.
أما في الماضي وفي الفترة بين عامي 2008-1994 فقد كانت سوريا ”تصدّر القمح إلى دول الجوار وتؤمّن حاجة الأردن بشكل كامل وجزءا من حاجة مصر وتونس، إضافة إلى دول أوروبا وخاصة إيطاليا لإنتاج المعكرونة“. لكن الإنتاج تراجع بين 2010-2009 بسبب الجفاف ليبلغ أدنى مستوى له منذ 29 عاما. والواقع أن الجفاف لم يحدث من تلقاء ذاته وبفعل المناخ وحده الذي لم يكن قاسياً دوماً، فقد عملت القرارات الخاطئة وما يمكن تسميته بالسقاية الجائرة للمشاريع العملاقة التي أدارها كبار الضباط والمقربون من رأس النظام في سوريا إلى تجفيف البحيرات العميقة للأنهار والآبار الجوفية، إضافة إلى بناء السدود غير المبررة لتلبية حاجة الفساد للمشاريع، ما حوّل ”سلة غذاء الشرق الأوسط“ إلى بلد يعاني من دمار القطاع الزراعي تماماً، وكل هذا قبل العام 2011.
أما أوكرانيا فهي، وكما هو معلوم، فمن أكبر مصدري القمح في العالم، وقد بلغ إنتاجها في الموسم 2020-2021 أكثر من 45,7 مليون طن من الحبوب. واليوم أصبح هذا الرقم في مهب الريح مع الحريق الذي يندلع على أراضيها.
بالطبع سيقود تحطيم مثل كل تلك النظم إلى تغييرات جذرية في أوضاع المرأة والتفاعلات الأساسية مع الهيئات الدينية، ومع فكرة التديّن ذاتها التي تقوم على هرمية لا توفرها قيم العولمة.
العالم يتغير بصورة مختلفة هذه المرّة إذاً، على مستوى الخرائط السياسية. في حين أن التغيير الحقيقي البعيد الأثر والمدى، هو ذاك الذي يجري على خريطة المجتمعات، فالتهوية مستمرة، ضاربة سياطها في التكتلات القومية والمذهبية، من دون غض الطرف عن كونها نوعاً من الاصطفاء الخاص والماكر لمن سيبقى ومن سيغادر، وما الذي سيخلّفه وراءه وما الذي سيتغير في المكان الجديد الذي سيصل إليه؟
تلفزيون سوريا
————————-
على خلفية الأزمة الأوكرانية.. التحالفات في سوريا عُرضة لانزياحات نوعية/ إياد الجعفري
تبدو التحالفات الإقليمية والدولية، على الرقعة السورية، عُرضةً لانزياحات نوعية في الاصطفافات والمعادلات الحاكمة لها، على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية. إذ تبدو المصالح الإسرائيلية أقرب إلى روسيا منها إلى الولايات المتحدة الأميركية، بصورة غير مسبوقة. فيما تبدو المصالح الروسية أقرب إلى إسرائيل منها إلى إيران. وتبدو طهران على مسافة أقرب مما هو معتاد، من واشنطن، وأبعد عن موسكو. أما نظام الأسد، فما يزال يلعب لعبته المعتادة، إذ يضع قدماً هنا، وأخرى هناك. فهو يدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وينشر صور بوتين بالعاصمة دمشق، فيما يرسل صندوق أسراره الأمني، علي مملوك، إلى طهران، في زيارة معلنة، وغير مسبوقة، ويستقبل قائد الحشد الشعبي العراقي المقرّب من إيران.
ومنذ يوم الجمعة الفائت، حدثت سلسلة تطورات دبلوماسية، تحمل أبعاداً استراتيجية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي زار موسكو سرّاً. وفيما كان عنوان الزيارة المُعلن هو التوسط لحل الأزمة الأوكرانية، بالاستفادة من علاقة إسرائيل المميزة مع أطراف رئيسية فيها – روسيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة-، كان محتوى المحادثات ينحو باتجاه ملفين أكثر أولوية لدى تل أبيب. الأول: استمرار التنسيق الإسرائيلي – الروسي، الذي يتيح لإسرائيل شن ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا، بحريّة كاملة، ودون أي عقبات روسية. والثاني: البحث عن نقاط تفاهم إسرائيلية – روسية حيال مساعي الغرب لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحقق.
وفيما لم تظهر أية نتائج إيجابية لمساعي الوساطة الإسرائيلية على خط الأزمة الأوكرانية، تبدت ترجمتان لنجاح المساعي الإسرائيلية في الملفين الآخرين. إذ اختُبر التنسيق الإسرائيلي – الروسي في سوريا، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حينما قصفت إسرائيل، فجر الاثنين، أهدافاً إيرانية في محيط العاصمة دمشق، بعد يومين من عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي من موسكو. وبالتزامن مع ذلك، اعتمدت موسكو استراتيجية ابتزاز لعرقلة الاتفاق النووي الإيراني، إذ طلبت ضمانات مكتوبة من الشركاء الغربيين في الاتفاق بأن عقوباتهم على روسيا، على خلفية غزو أوكرانيا، لن تؤثر على التعاون الروسي الاقتصادي والاستثماري والتقني والعسكري مع إيران.
وهكذا نجحت إسرائيل في اختراق مساعي أطراف الاتفاق النووي الإيراني، لإعادة إحيائه، من قناة غير متوقعة –روسيا- هذا التطور، أغضب الأميركيين والأوروبيين، والإيرانيين أيضاً. وطلبت طهران توضيحات من موسكو، فكان الرد الروسي تأكيداً لنية الدبلوماسية الروسية ممارسة لعبة الابتزاز بذرائع واهية.
وبعيد عقد الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، كان لروسيا دور بارز في تنفيذه. تحديداً في جانبين، نقل كميات من اليورانيوم المخصّب من إيران إلى أراضيها، وتوفير دعم لإيران في برنامجها النووي المدني. ناهيك عن دورها البارز في الوساطة لإعادة إحياء الاتفاق بعد إجهاضه، في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
الانقلاب الروسي على مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني، يبدو لأسباب تكتيكية مرحلية، متعلقة بابتزاز جميع الأطراف، بما فيهم إيران والأميركيون والأوروبيون، على خلفية التهديد بفرض عقوبات على صادرات روسيا من النفط. فموسكو غير مستعدة لأن ترى النفط الإيراني يحل محل نفطها في الأسواق الدولية. وهي مستعدة لتخريب الاتفاق النووي، إن كان ذلك سيحدث فعلاً. لكن، على المدى البعيد، ليس لروسيا مصلحة في عدم إحياء الاتفاق، إذ لا مصلحة لها في أن ترى إيران، نووية. فيما الأخيرة تتلهف لرفع العقوبات عنها، ولعودة نفطها إلى الأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعاره الهائل. بدورها، تراهن إسرائيل على المزيد من العرقلة للاتفاق الذي تراه لا يخدم مصالحها، إذ إن عودة النفط الإيراني، دون قيود، إلى الأسواق، في ظل أسعار غير مسبوقة منذ 14 عاماً، يعني ضخ إيرادات مالية هائلة في الخزانة الإيرانية، ستنعكس تعزيزاً للمساعي الإيرانية للهيمنة في المنطقة، والتي تعدها إسرائيل، تهديداً لأمنها القومي. خاصة في سوريا ولبنان.
وفيما تبدو اللوحة معقدة للغاية، تتابع التطورات الدبلوماسية المفاجئة. إذ زار وفد أميركي رفيع المستوى، فنزويلا، الحليف الروسي المقرّب، والخصم اللدود لواشنطن في أميركا اللاتينية. الزيارة غير المسبوقة منذ سنوات، جاءت في سياق استراتيجية أميركية للتقرّب من حلفاء روسيا. إذ تواصلت الدبلوماسية الأميركية مع الصين. بالتزامن مع تحركها نحو كراكاس. التحرك نحو الأخيرة كان عنوانه بحث مدى استعداد فنزويلا للتراجع عن تحالفها الوثيق مع موسكو، وأن تكون بديلاً محتملاً لإمدادات النفط، في حال قررت واشنطن بالفعل، فرض قيود على صادرات الخام الروسي.
نظام نيكولاس مادورو، الذي يحكم كراكاس، كان قد واجه حملة عقوبات وضغط دبلوماسي غربي بغية الإطاحة به. ونال مادورو دعماً سخياً من موسكو، كان أحد أسباب صموده على كرسي الحكم. لكن كلفة هذا الصمود كانت تدهوراً معيشياً غير مسبوق لشعبه. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الموقف الذي سيتخذه مادورو من ملامح الانفتاح الأميركي عليه. هذا التحرك الدبلوماسي الأميركي، بمحتواه الاستراتيجي، وهو الانفتاح على حلفاء روسيا، لجذبهم بعيداً عنها، يحيلنا إلى تساؤل ملح: هل يمكن أن يتكرر ذات التحرك الأميركي، باتجاه نظام الأسد في سوريا، خاصة مع رغبة واشنطن الحثيثة بعقد اتفاق مع إيران؟
وهكذا تتعقد لوحة التطورات على خلفية الأزمة الأوكرانية، التي من المرجح أن تطول وتتعمق، وفق توقعات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها مؤخراً. الأمر الذي سيجعل أفق التحالفات في سوريا مفتوحاً على تغيرات دراماتيكية.
تلفزيون سوريا
—————————
ما يعنينا وما لا يعنينا!/ حازم صاغية
ترتفع أصوات في العالم العربيّ تستهجن الاهتمام بالحرب الروسيّة الأوكرانيّة الراهنة، وتحديداً بمأساة أوكرانيا. الحجّة أنّ لدينا، نحن العرب، مآسينا في فلسطين والعراق واليمن (وغالباً ما لا تُذكر سوريّا ولبنان إذ يصعب اتّهام أميركا وإسرائيل وبلدان الخليج بمآسيهما).
إذاً، وبكثير من اللطم الممزوج بالإدانة الأخلاقيّة، لماذا الاكتراث بمأساة بعيدة؟
لوهلة أولى، نضع جانباً اختلافات التقدير السياسيّ والانقسام حول الحرب الحاليّة. فالأخيرة تعنينا بذاتها لمجرّد كونها حدثاً يحدث في عالمنا، لكنّها تعنينا خصوصاً كونها حدثاً يحدث في أوروبا. فحربا 1914 و1939 اللتان اندلعتا في تلك القارّة، وبين أبنائها، صارتا حربين «عالميّتين» كما نعلم جيّداً. ومَن هم متشائمون بيننا يتحدّثون اليوم عن «حرب عالميّة ثالثة» قد ينتهي إليها هذا النزاع الدائر في أوكرانيا، أي في أوروبا. أمّا أولئك الذين يفوقونهم تشاؤماً، وربّما حكمةً ومعرفةً، فبدأوا ينبّهوننا إلى أنّ الحرب المحتملة قد تأخذ شكلاً نوويّاً!
فأوروبا لا تزال مركز العالم، وإن انتزعت آسيا والصين في العقدين الأخيرين بعضاً من هذه المركزيّة. أمّا نحن فتأثّرُنا بما يحصل فيها يفوق تأثّر سوانا من مناطق وشعوب: الحرب العالميّة الأولى صنعت معظم دولنا. انهيار السلطنة العثمانيّة كان وثيق الصلة بتلك الحرب. الحرب العالميّة الثانية صنعت معظم استقلالات بلداننا. معركة العلمين، على حدود مصر مع ليبيا، كانت إحدى معاركها الأساسيّة والحاسمة. قيام إسرائيل نفسها ما كان ليكون ممكناً لولا المحرقة النازيّة ليهود أوروبا… تعداد الأمثلة التي تدلّ على تأثّرنا بأحداث تلك القارّة وبحروبها لا تتّسع له المجلّدات، وإن كانت لا تلغي، بطبيعة الحال، أنّ ما يحصل عندنا يؤثّر أيضاً في أوروبا: يكفي تذكّر النتائج التي ترتّبت على ارتفاع أسعار النفط في أواسط السبعينات، أو الصلة الوثيقة بين موجات اللجوء والهجرة وبين الانبعاث الشعبويّ… هذا من غير أن نذكّر بتواريخ أقدم عهداً، كالحروب الصليبيّة والنزاع على أسبانيا والمواجهات العثمانيّة – الأوروبيّة، وقبلها جميعاً توسّط العرب والمسلمين بين ثقافة الإغريق وبلوغها إلى أوروبا.
كلّ ذلك يُفترض أنّه من البديهيّات التي لا تعاملها الأفكار الأبرشيّة والانعزاليّة بوصفها بديهيّات.
والحال أنّ الوجهة هذه لا تعدو كونها تتويجاً لمسار تاريخيّ مديد بدأ بتقريب أمكنة العالم وتوحيد أزمنته التي صارت خطّيّةً بعدما كانت دوريّةً، بحيث أعطي الفعلُ الإنسانيّ وظيفة كانت حكراً على تقلّب الفصول ودوران الأفلاك. هكذا، وفي سياق عمليّة كهذه، حلّ التغيّر محلّ الثبات، وغيرُ المتوقّع محلّ المتوقّع.
لاحقاً، مع الثورة العلميّة ومع الرأسماليّة الصناعيّة التي وحّدت العالم، بالغزو طبعاً، ولكنْ أيضاً بسكك الحديد والقنوات المائيّة والمدارس وسواها، حصلت النقلة النوعيّة الكبرى في تصوّر الكون واحداً والزمن واحداً. لقد ضُغط الزمن كما ضُغط المكان، بالقطار والسيّارة والطائرة والتليفون والراديو والتلفزيون، قبل أن تضيف الثورة المعلوماتيّة والعولمة الاقتصاديّة مساهماتهما، من الفاكس إلى الإنترنت، ومن الكابلات البحريّة إلى الأقمار الصناعيّة. وفي هذا كلّه أدّت التجارة دورها النوعيّ تبادلاً وصياغةً لحياة البشر وأذواقهم ومتطلّباتهم…
ضدّ هذا كلّه شكّلت السياسة، بأعرض معانيها، حلبة الصراع التي تعترض طريق العالم إلى وحدته. والصراع هذا، وإن حرّكه قدر ليس قليلاً من التفاوت ومن العنف اللذين ينطوي عليهما مسار الوحدة، فقد وظّفه القوميّون والشعبويّون، في الغرب كما في الشرق، لا لوقف حركة الوحدة مع الآخر فحسب، بل أيضاً لوقف المعرفة بهذا الآخر، دع جانباً التعاطف معه في مآسيه.
إنّ نظريّة «مآسي أوروبا لا تعنينا» وجدت امتحانها الأكبر في تجاهلنا أموراً كالمحرقة اليهوديّة بحجج من نوع أنّنا لم نرتكبها، وأنّنا، نحن العرب، مَن دفع ثمنها. وهي حجج قد تفسّر جزئياً ذاك التجاهل لكنّها لا تبرّره إطلاقاً. أمّا الامتحانات التي توالت، وكنّا نرسب فيها، الواحد تلو الآخر، فكانت كثيرة جدّاً، يجمع بينها عنوان مشترك: النظر إلى الكون من ثقب «قضايانا»، وهي تارةً «مركزيّة» وطوراً «بوصلة».
وهذا لئن ضيّق نظرتنا إلى العالم، فالأخطرُ أنّه عاد على قضايانا نفسها بالهزائم والإخفاقات. ذاك أنّ نظريّة «مآسيهم لا تعنينا» تتواطأ فعليّاً مع الذين يتسبّبون بتلك المآسي، أكانوا الفاشيّة مرّة، والشيوعيّة السوفياتيّة مرّة أخرى، والروسيّة البوتينيّة اليوم. وهؤلاء لم يربحوا، ولن يربحوا، لأسباب في عدادها أنّ العالم لا يعنيهم. هكذا يقودنا عدم الاكتراث إلى شراكة من نوع آخر، شراكةٍ في هزائم أولئك المهزومين بعد مشاركتهم نظريّةَ إدارة الظهر إلى العالم.
الشرق الأوسط
————————–
المنظور الإسرائيلي للحياد في الأزمة الأوكرانية وتداعياته/ شفيق شقير
بَنَت إسرائيل حيادها في الأزمة الأوكرانية على لعب دور الوسيط، لكن حقيقة حيادها تقوم على احتفاظها بحقها في سياسة مستقلة خاصة في سوريا لحفظ أمنها ولو تطلبت التعاون مع روسيا.
تدرك إسرائيل بالنظر إلى طبيعة الأزمة الأوكرانية وسياق تطورها، أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف قد تزيد من ضغوطها على حلفائها لينتظموا إلى جانبها في مواجهة روسيا، خاصة أنها -أي واشنطن- إلى جانب أوروبا، تعتبر المواجهة مصيرية، وتحتاج إلى كل الأدوات والجهود لمواجهة التمدد الروسي الذي “يهدد” مجمل دول القارة الأوروبية، لا بل دول العالم. وبالمقابل، لا جدال في أن إسرائيل تسعى لأن تكون في منطقة أقرب للحياد في “الأزمة الأوكرانية”، خشية من تداعيات أزمة دولية قد تغيِّر من موازين القوى الدولية والإقليمية واتجاهها بما يتعارض مع مصالح إسرائيل، هذا من جهة، كما أنها من جهة أخرى تضع إسرائيل في موقف يصعب فيه التوفيق بين حلفها مع الولايات المتحدة الأميركية، عمقها الحيوي وداعمها الاستراتيجي، وتفاهمها مع روسيا التي أصبحت تجاورها في سوريا، وتحتاجها في عدد من ملفات المنطقة وسواها.
يركز هذا التعليق على فهم طبيعة الحياد الذي تنشده إسرائيل، والتداعيات التي بانتظار المنطقة في هذا السياق.
مخاوف إسرائيلية
صوَّتت إسرائيل، في 2 مارس/آذار 2022، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها كانت قد خفضت مستوى تمثيلها في الجلسة عينها إلى مستوى نائب السفير لتخفيف وقع المشاركة، وتحفظت على أية مساعدة عسكرية لأوكرانيا، وسارع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، إلى زيارة موسكو، في 5 مارس/آذار 2022، والتقى الرئيس الروسي، بوتين، ما يقرب من ثلاث ساعات، بموافقة من واشنطن -كما أُعلن- وليطرح إسرائيل وسيطًا بين أطراف الأزمة الأوكرانية، وبين روسيا والغرب. أما دوافع إسرائيل لهذا الدور، فهي نابعة من تقديرها للمخاطر التي تواجهها في جوارها، لاسيما أن هناك على الأقل تطورين كبيرين في المنطقة، تحتاج إلى علاقة منتظمة مع روسيا للتعامل معهما:
أولًا: المشروع النووي الإيراني، والذي بلغ مرحلة متقدمة بحسب التقدير الإسرائيلي، وتخشى إسرائيل أن تصبح إيران عند “العتبة النووية” وهو ما تسعى للحؤول دونه بمساعدة المجتمع الدولي، وروسيا من الدول الكبرى المؤثرة في هذا الشأن، وعضو دائم في مجلس الأمن، ومعنية بضبط انتشار الأسلحة النووية، ومنخرطة في أزمات المنطقة، كما لديها علاقات جيدة مع إيران.
ثانيًا: التمدد العسكري الإيراني في المنطقة، الذي يشمل لبنان وسوريا، خاصة في الأخيرة حيث مسرح المواجهة الأساسي بالنسبة لإسرائيل وتتشاركه مع روسيا، وهو التمدد الذي أعطى حزب الله دوره الإقليمي، وضاعف قدرة إيران على منافسة إسرائيل في الإقليم وتهديد نفوذها أو حتى “تهديدها”. ورغم الوجود الروسي في سوريا، استطاعت إسرائيل أن تطور آلية في التواصل الأمني مع روسيا بما يمنع أي احتكاك أو مواجهة مع القوات الروسية، ولا تزال إسرائيل مستمرة في غاراتها على سوريا وتضعها تحت عنوان حماية أمنها واستهداف شحنات الأسلحة لاسيما الصواريخ الدقيقة منها، التي ترسلها إيران إلى حزب الله، وكذلك مخازن أسلحة وطائرات مسيَّرة، والتي قد تكسر ميزان القوى مع إسرائيل في أية مواجهة قادمة، كما أنها قد تستهدف أحيانًا مواقع إيرانية هناك.
لا شك في أن إسرائيل تتعامل مع الوجود الروسي في سوريا على أنه سيكون طويل الأجل، وذلك بالنظر إلى طبيعته حيث لموسكو قاعدتان عسكريتان أساسيتان، بحرية في طرطوس وجوية في حميميم. وكذلك بالنظر إلى حاجة إسرائيل لها؛ حيث تتشارك روسيا مع إيران دعم الرئيس الأسد ومؤازرة نظامه، كما يتشارك البلدان هيمنة ونفوذًا يكادان يكونان مطلقيْن في دمشق. وهو ما يجعل روسيا -بالرؤية الإسرائيلية- منافسًا قويًّا محتملًا لإيران على الأسد وعلى سوريا نفسها، رغم أنها في سوريا حتى اللحظة حليفة لإيران في مواجهة المعارضة السورية ومؤيديها.
واعتمدت إسرائيل روسيا بالفعل كأحد الفاعلين الأساسيين لموازنة النفوذ الإيراني في سوريا والحد منه، كما أنها تمثل قناة تواصل أساسية وفاعلة مع الرئيس الأسد بعيدًا عن النفوذ الإيراني -إلى جانب الدور الإماراتي إلا أنه محكوم بالتحفظ الأميركي- وكذلك كانت روسيا من حين إلى آخر قناة تواصل مع الإيرانيين أنفسهم، من ذلك مثلًا الاتفاق على إعادة تموضع الميليشيات المدعومة من إيران بحيث تكون بعيدة نسبيًّا عن الحدود مع الجولان وحدود إسرائيل، أو لخفض احتمالات المواجهة بين إسرائيل وإيران (خاصة أن البلدين انخرطا في حروب ظلٍّ ربما لم تنته)، وحتى بين حزب الله وإسرائيل في لبنان وعموم المنطقة وأسباب الحرب قائمة على الدوام، فضلًا عن أدوار أخرى على هذا الصعيد.
والجدير بالذكر أن إسرائيل بقيادة نتنياهو كانت قد أيدت خروج واشنطن -في ظل إدارة الرئيس، دونالد ترامب- من الاتفاق النووي، ومن ثم تحفظت على المفاوضات النووية في فيينا التي انخرطت فيها إدارة الرئيس، جوزيف بايدن، خشية من أن يؤدي الاتفاق الجديد فيما يؤدي إليه، إلى إطلاق يد إيران في المنطقة بمقابل تقييد يدها، فضلًا عن مخاوف أخرى تتعلق بأمنها، فأعلنت أنها ستكون مستقلة في موقفها إزاء إيران عن الولايات المتحدة الأميركية، بما يحفظ أمنها ومصالحها، وذلك رغم تأكيد واشنطن مرارًا وتكرارًا وفي أكثر من مناسبة التزامها بأمن إسرائيل.
تداعيات
وضعت الأزمة الأوكرانية مفاوضات فيينا من حيث الأهمية في مرحلة تالية، وأصبحت تفصيلًا لكن مهمًّا في ظل المواجهة مع روسيا والسعي إلى عزلها؛ حيث قال الرئيس الأميركي، بايدن، بخصوص الأخيرة: “عندما يُكتب تاريخ هذه الفترة، ستكون حرب بوتين على أوكرانيا قد جعلت روسيا أضعف وبقية العالم أقوى”، وكلامه يشي أن واشنطن ليست عازمة على إجبار روسيا على التراجع عن “غزو أوكرانيا” ولا الإتيان بها إلى طاولة المفاوضات فحسب، بل أيضًا تهدف لإضعاف روسيا وهو أحد السيناريوهات التي قد تتحقق نسبيًّا أو يتحقق بعضها.
بالنسبة لإسرائيل، فإن أي ضعف روسي يؤدي أو يقترن بضعف إيران في المنطقة لن يقلقها وقد ترحب به، ولكن لا يمكن الجزم بهذه النتيجة، بل قد تكون معاكسة، لأن العقوبات الغربية الشديدة على روسيا قد تدفع أميركا والغرب نحو تسهيل عقد اتفاق نووي يرفع العقوبات عن إيران حتى تزيد من إنتاج النفط بما يخفف من الاعتماد على الإنتاج الروسي، ويسهم في لجم صعود أسعار النفط ومشتقاته عالميًّا، وهذا بالنتيجة يصب لصالح تقوية الجانب الإيراني.
هذه المعادلة ستكون الأسوأ على إسرائيل، لاسيما إذا ما امتد أجل الأزمة في أوكرانيا وتفاقمت أكثر، بالموازاة مع استمرار تراجع اهتمام أميركا بالمنطقة لتراجع أهميتها بالنسبة لها، فحينها أي ضعف روسي سيصبُّ في مصلحة القوى الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها إيران. وبذا، ستجد إسرائيل نفسها في مواجهة ظروف مواتية أكثر لإيران ومعاكسة لها، سواء كانت إسرائيل في تربص أو مواجهة معها، أو في تفاوض ومساومة.
وعلى صعيد آخر، فإن انضمام إسرائيل إلى تحالف إقليمي برعاية من الناتو أو أميركا، يضمها مع بعض دول المنطقة لاسيما العربية منها في مواجهة إيران، أحد الخيارات التي طالما كانت مطروحة إسرائيليًّا على الطاولة ومن أطراف أخرى، بات الآن أصعب من ذي قبل مع اندلاع الأزمة في أوكرانيا، لأن خشية روسيا من تشكُّل محور مناهض لها في المنطقة قد تضاعف.
ومن الممكن أيضًا أن تذهب الأمور في اتجاه أسوأ من ذلك جميعًا: أن تزداد متانة التفاهم الروسي/الإيراني ليكون تحالفًا بمعايير أعلى من ذي قبل، وهو أحد السيناريوهات التي قد تنتج عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.
هذه جميعًا تحتم على إسرائيل أن تكون في وسط الأزمة الأوكرانية وأن تتابع تفاصيلها، وأن تصوغ حيادها بما يلائم مصالحها.
حياد ولكن!
إن الحياد الذي تسعى إليه إسرائيل بخصوص الأزمة الأوكرانية هو ذاك الذي يعفيها من واجب الانحياز، إلى أميركا والمعسكر الغربي في مواجهة روسيا، وهو ما يؤمِّنه لها قيامها بدور الوساطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى كل أطراف النزاع، ولعلها استطاعت حتى اللحظة تحقيق ذلك إلى حدٍّ بعيد وبموافقة أميركية. ولكن الشق الآخر الذي تسعى إليه أيضًا يكمن في سوريا، وهو المحافظة على التواصل الأمني مع روسيا بخصوص غاراتها ونشاطاتها العسكرية والأمنية هناك، وهو ما يمكن قراءته في زيارة بينيت لموسكو ولقائه مع بوتين، والذي جاء في يوم راحة يهودي “ديني” أي يوم “السبت”، وأعقبه بيومين فقط غارات إسرائيلية على سوريا أعلنت إيران مقتل اثنين من عناصرها من جرَّائها. وحتى هذا المستوى من الاستثناء قد لا يكفي إسرائيل إذا ما لم تقدم أميركا بدائل للدور الروسي والذي سيصبح أكثر إلحاحًا في حال التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا، وما قد يعنيه ذلك من انتعاش قدرات إيران في المنطقة مرة أخرى، واحتمال غلبة الدور الإيراني على الدور الروسي في المنطقة.
وفضلًا عن كل ما سبق، إن ردَّ الفعل الدولي على الاجتياح الروسي لأوكرانيا من حيث الإدانة والعزل، ليس من مصلحة إسرائيل أن يتحول لنموذج في العلاقات الدولية ويستقر فيها -ولو إلى جانب ازدواجية المعايير المهيمنة أصلًا- وهي مارست ولا تزال هذا الاجتياح في فلسطين والجوار العربي.
إن الحياد بحقيقته يعني أن تستمر إسرائيل في استقلالها عن السياسة الغربية والأميركية في مواقفها من روسيا أو إيران وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، بما يسمح لها بعقد تفاهمات وإطلاق مبادرات وحتى لو تطلب الأمر دفع أثمانها بمزيد من الاستثناءات على صعيد مواجهة روسيا وبموافقة أميركية تحميها من بقية الحلفاء، أي هو حياد يضع مصلحة إسرائيل في هذا الشأن بالذات أولًا بذريعة أنه ضرورة لوجودها، وعلى الحلفاء أن يتكيفوا معه وخاصة الحليف الأميركي الذي تعهد بالتزام أمن إسرائيل وأن الاتفاق النووي لن يؤثِّر على ذلك.
نبذة عن الكاتب
شفيق شقير
باحث في مركز الجزيرة للدراسات، متخصص في شؤون المشرق العربي، والحركات الإسلامية. حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية (فرع القانون والفقه وأصوله). تغطي اهتماماته البحثية الأزمات الداخلية في المشرق العربي والنزاع العربي-الإسرائيلي، وكذلك التيارات الإسلامية السُّنِّية والشيعية، والجماعات الجهادية، ومقولاتها الفكرية والفقهية وتوجهاتها السياسية. له مشاركات وبحوث عدة، منها: حزب الله: روايته للحرب السورية والمسألة المذهبية، “علماء” التيار الجهادي: الخطاب والدور والمستقبل، الجذور الأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية، الحراك اللبناني: السياق العربي وتحديات نسخة الطائف الثالثة.
——————————-
تداعيات ومخاطر ظاهرة المقاتلين الأجانب في أوكرانيا/ لقاء مكي
بدأ الآلاف من المقاتلين الأجانب من عشرات الجنسيات، بالوصول إلى أوكرانيا للقتال ضمن ما يعرف بـ(الفيلق الدولي) ضد القوات الروسية، فضلًا عن معلومات بتجنيد مرتزقة محترفين. من المتوقع أن يكون لوجود هؤلاء المقاتلين تداعيات مستقبلية تخص الحرب ذاتها والأمن الدولي.
أعلن الجيش الأوكراني عن وصول أول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية، ليكونوا جزءًا مما أسمته كييف (الفيلق الدولي)، وقد أعلن الرئيس، فلوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستستقبل 16 ألف متطوع يمثلون (الدفعة الأولى من المقاتلين الأجانب الذين (سيدافعون عن حرية أوكرانيا وشعبها)، فيما قال وزير الخارجية، دميترو كوليبا: إن عدد المتطوعين بلغ 20 ألفًا من 52 دولة ومعظمهم ينحدرون من أوروبا.
كان زيلينسكي قد أعلن رغبة بلاده باستقبال (متطوعين دوليين)، في السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، أي في اليوم الثالث من الحرب، وهو ما بدا لافتًا في حينه؛ إذ لم تكن أوكرانيا تعاني من حاجة فعلية للجنود المقاتلين، كما أنها بدأت باتخاذ إجراءات للتعبئة العامة، ومنعت جميع الذكور من ذوي الأعمار (18-60) عامًا من مغادرة البلاد مع موجات الفارِّين من المعارك، ويمثل هؤلاء نسبة لا تقل عن 27% من عدد السكان في أوكرانيا، أي نحو 12 مليون شخص مما يقارب 44 مليون نسمة، ويعني ذلك أن البلاد كان لديها بالفعل قدرات لتجنيد قوات احتياط ضخمة. ولن يضيف عدة آلاف من المقاتلين الأجانب قدرات قتالية حاسمة لها.
أشارت تصريحات لمسؤولين في كييف عن أن فكرة (الفيلق الدولي) تهدف للسماح بالتعبير عن التضامن العالمي ضد الهجوم الروسي، لكن هذا السبب لم يبد كافيًا للقبول بفكرة إشراك مقاتلين أجانب في الحرب، لاسيما مع حساب التداعيات المستقبلية المحتملة وزيادة تعقيد الأزمة، وتقليص فرص السيطرة على تصاعدها. ومع ذلك، فقد كان مفاجئًا أن تحظى الدعوة الأوكرانية بتأييد علني من الدنمارك وبريطانيا، من غير أن تبدي معظم دول الغرب، رفضًا على الصعيد السياسي، فيما كان لافتًا اعتراض قائد هيئة الأركان البريطانية على الفكرة واعتبارها غير قانونية وغير مفيدة، ولكن من دون أن يمنع ذلك مغادرة متطوعين بريطانيين بالفعل إلى أوكرانيا.
لم تقدِّم كييف تفسيرات عسكرية لإجراءاتها لاسيما في وقت إعلانها المبكر على الأقل؛ ما أثار تكهنات بأن يكون الأمر غطاء لمشاركة عسكريين من دول غربية، متخصصين بالأسلحة النوعية المتقدمة، بالحرب تحت تسمية متطوعين لتجنب مواجهة مباشرة لبلدانهم مع روسيا، لكن ذلك يبقى مجرد تفسير لا أدلة واقعية حوله.
وعَدَا عن المتطوعين، فإن أوكرانيا بدأت -حسب مصادر إعلامية- باستقدام المئات من المرتزقة التابعين لشركات أمنية للقتال ضمن “الفيلق الدولي”، واستشهدت هذه المصادر بإعلان في موقع (silent professionals) الأميركي المتخصص بالأعمال الأمنية، عَرَضَ الحصول على عمل فوري في أوكرانيا لمهام “أمنية خاصة ودفاعية وفي البحث والتنقيب والحماية” وسوى ذلك. واشترط الإعلان توافر خبرات قتالية احترافية في الخارج، مع تفضيل للمقيمين في أوروبا، وبأجر يومي يتراوح ما بين 1.000- 2.000 دولار أميركي مع علاوات بعد إنهاء المهمة.
وحسب موقع (MEE)، فإن شركات أخرى تقوم بتوظيف متعهدين وتعرض عليهم أجورًا تتراوح ما بين 2.000- 3.000 دولار في اليوم، وربما زاد عدد الجنود المحترفين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا عن 1000 شخص.
من المتوقع أن يسهم المرتزقة الأجانب في معارك المدن بشكل خاص، أو في عمليات المقاومة التي يمكن أن تندلع في حال فرضت القوات الروسية سيطرتها على العاصمة، كييف، وعلى المدن الكبرى، لكن من غير الواضح قدرة (المتطوعين) من المدنيين غير المحترفين القادمين من دول جرى الإعلان بالفعل عن وجود متطوعين من مواطنيها، على تأدية دور فعال في القتال، لاسيما أنهم ينتمون لبلدان لم تشهد حروبًا أهلية يمكن أن تكون قد شهدت انخراطهم في أية خبرات قتالية. ومن بين هذه الدول، دول أوروبية مختلفة فضلًا عن اليابان والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وقامت سفارات أوكرانية بنشر إعلانات تدعو مواطني بلدان مختلفة إلى (التطوع)، مع وعود بتقاضي أجور شهرية تعادل ما يتقاضاه الجندي الأوكراني، وصدرت اعتراضات رسمية علنية في الجزائر والسنغال على هذه الإعلانات.
تكرار تجربة الاستعانة بالمرتزقة
لا يمكن اعتبار وجود مرتزقة في الحرب الأوكرانية أمرًا خارجًا عن المألوف، فالولايات المتحدة استعانت بالفعل بالمرتزقة الذين وفرتهم شركة بلاك ووتر الأميركية للقتال إلى جانب قواتها في أفغانستان والعراق، وقاموا بالفعل بمهام ميدانية واسعة ضد المقاومة الأفغانية والعراقية، واتُّهِموا بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، وهو ما يمكن أن يقوم به المرتزقة في الحرب الراهنة، وذلك أحد أسباب استخدامهم؛ حيث يتجرد هؤلاء من أي معيار أخلاقي أو قانوني تلتزم به الجيوش الرسمية، فيقومون بجرائم وانتهاكات خطيرة، يمكن للدول المشغِّلة لهم التنصل منها.
ويبدو أن روسيا شاركت أوكرانيا بالاستعانة بالمرتزقة، لكن من دون إعلان أو معلومات رسمية؛ حيث انتشرت منذ اليوم الرابع للمعارك معلومات عن دخول نحو 400 مقاتل من شركة فاغنر الأمنية الروسية، إلى كييف، في مهمة محددة لاغتيال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، حسب صحيفة التايمز البريطانية، وقالت: إن وجود هؤلاء هو جزء من مخطط يعود لعدة أشهر.
وتتولى فاغنر، مهام أمنية في إفريقيا ومالي وموزمبيق وجنوب السودان، وقد أبدت فعالية عالية في دعم الأنظمة الحاكمة هناك، كما أن لديها أنشطة أمنية في سوريا، ويسود اعتقاد بوجود علاقة مباشرة بين هذه الشركة والكرملين، لكن الأخير ينفي ذلك. ويمثل دخول فاغنر إلى ساحة العمليات الروسية تطورًا مؤثرًا في بعض المجريات القتالية لاسيما حرب المدن ومعركة السيطرة على كييف بشكل خاص.
ويبدو أن روسيا باتت تستعين بعناصر قتالية أجنبية من خارج عناصر المرتزقة المحترفين، وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن موسكو جنَّدت مؤخرًا سوريين يجيدون حرب المدن للقتال إلى جانبها في أوكرانيا، ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن هؤلاء المقاتلين السوريين موجودون بالفعل الآن في روسيا، وقد ينضمون إلى المعارك في أي وقت، لكن أعدادهم ليست معروفة، وقد رفض نفس المسؤولين الأميركيين التعليق على وجود مقاتلين سوريين أيضًا يقاتلون مع الجانب الأوكراني ضد القوات الروسية.
من المحتمل بقوة أن يكون لوجود المرتزقة على جانبي الحرب في أوكرانيا تأثير في مجريات المعارك الآن أو في مراحل لاحقة من حروب المدن، أو المقاومة، وكذلك في وقوع انتهاكات منهجية ومتكررة ضد المدنيين أو مخالفة قواعد وقوانين الحرب، لكن من غير المتوقع أن تحصل تداعيات غير متوقعة مستقبلًا، فهؤلاء سينتقلون بعد انتهاء مهامهم إلى مواقع جديدة ويخدمون زبائن جددًا مقابل ثمن، لكن المشكلة الحقيقية ستكمن في وجود (المتطوعين) أو المرتزقة غير المحترفين الذين يجري استقدامهم للمشاركة في الحرب ثم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو بلدان أخرى.
التداعيات المحتملة
فضلًا عن التأثير العملياتي المحدود وربما العكسي لوجود متطوعين يُفترض أنهم بلا خبرات قتالية احترافية، فإن الأمر برمته ما زال بلا ضوابط تنظيمية، ولا إجراءات مراقبة وتقصٍّ، كما أنه لم يعالج مخالفته الصريحة للقوانين الدولية والوطنية بمنع القتال لصالح قوى أجنبية. وإذا ما استمر هذا الخلل في بنية الدعوات الراهنة للتطوع، فإن تداعيات مباشرة يمكن أن تنشأ مستقبلًا على صعيد الأمن الغربي والأوروبي وربما في بلدان أخرى مختلفة في العالم، يمكن إجمالها فيما يأتي:
إمكانية ظهور أو تصاعد حمى التطرف في بقاع عديدة من العالم، مع وجود بيئة مثالية خلال الحرب، لتلقين المقاتلين الأجانب آليات العنف واستسهال القيام به من دون ضبط عسكري وفكري يتلقاه عادة الجنود النظاميون.
أن وجود متطوعين أجانب في حرب ببلاد غريبة، هو بالأساس جزء من سياق أيديولوجي أو اعتباري؛ حيث ينظر المتطوع إلى أحد طرفي النزاع على أنه مع الحق، فيما يمثل الطرف الآخر الباطل، وغالبًا ما ينظر الغربيون إلى أوكرانيا على أنها الضحية أمام عدوان روسي واضح، ومن المحتمل بقوة أن تعزز الحرب قناعاتهم هذه وتزيد من جرعة كراهيتهم لأحد طرفي الصراع. إن هذا الموقف هو بحدِّ ذاته موقف أيديولوجي يمكن أن يتحول إلى سياق تنظيمي وربما تخريب متطرف لاحقًا.
وجد جمهور اليمين المتطرف في أوروبا فرصة كبيرة لهم للقتال ضد روسيا، ويبدو أن غالبية المتطوعين من بين صفوفهم. وحسب الباحثة في جامعة ملبورن، سارة ميغر، فإن هناك عددًا من المتطوعين الغربيين ساندوا أوكرانيا عسكريًّا بعد حرب عام 2014، وكانت غالبيتهم من اليمين، ووجدت ميغر أن الدفاع عن أوكرانيا من الغزو الروسي يمثل لمثل هؤلاء خطوة ضرورية في “كبح القوة السياسية الخبيثة والدفاع عن القيم الغربية”. ولا يمكن أن يكون تصاعد قوة اليمين وانخراطه في نزاع مسلح داخل أوروبا حدثًا عاديًّا، فاليمين الأوروبي الذي تتصاعد قوته السياسية باستمرار مدفوعًا بكراهية الأجانب واللاجئين بشكل خاص، سيتحول إلى قوة أيديولوجية مؤهَّلة للعنف واستخدام أدواته، وهو ما ينبغي أن يشكِّل مصدر قلق عميق للغرب.
من المتوقع أن يشارك متطوعون من خارج أوروبا إلى جانب أوكرانيا، وربما وصل بعضهم بالفعل. إن كثيرًا من هؤلاء من دول إفريقية وشرق أوسطية ومن أماكن أخرى في العالم الثالث، قد لا يكون لديهم دوافع أيديولوجية أو سياسية أو أخلاقية للقتال مع هذا الجانب أو ذاك، والغالب أنهم مدفوعون بحاجات اقتصادية، أو بتوقع وجود فرص لاستغلال (فوضى) الحرب لعبور الحدود بشكل من الأشكال نحو دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكون أسهل طريق للجوء إلى الغرب، دون أن يكون لمخاطر الحرب أثر مقابل فرصة ممكنة نظريًّا على الأقل للوصول إلى أوروبا.
لن يكون مستبعدًا أن يصل ضمن المتطوعين، أفراد ذوو صلة بتنظيمي الدولة أو القاعدة. سيتلقى هؤلاء تدريبًا من خبراء الناتو على أسلحة نوعية، وستكون لهم أجندة واضحة لا علاقة لها بمصالح أي من أطراف النزاع، تتلخص بالتجمع والعمل لاحقًا ضد المصالح الأمنية في أوروبا.
لقد اعتبرت دول كثيرة في العالم الحرب الأفغانية منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، مصدر إنتاج لمتطرفين وإرهابيين كانوا بالأصل (مقاتلين متطوعين) من الشرق الأوسط، شاركوا بالحرب ضد الغزو السوفيتي بتشجيع من دولهم، وبدعم عسكري وتدريبي ومالي أميركي، وتعرَّف غالبيتهم على ما يعتبر (فكرًا متطرفًا) خلال الحرب، وتلقى خبرات قتالية واسعة استُخدمت لاحقًا في العمليات الإرهابية. ولن يكون بالضرورة أن تتكرر تجربة (الأفغان العرب) بتفصيلاتها في الحالة الأوكرانية الراهنة، لكن النمط لا يختلف كثيرًا حتى الآن، ولو استمر دون تنظيم، فقد لا تبتعد النتائج عن التجربة الأفغانية.
نبذة عن الكاتب
لقاء مكي
باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، وأستاذ دكتور في الإعلام والدعاية من جامعة بغداد
———————————-
توماس فريدمان: ليس أمام بوتين في أوكرانيا غير الخسارة وهذا يرعبني
سيتضح أكثر فأكثر أن أكبر مشاكل العالم مع بوتين في أوكرانيا هي أنه سيرفض الخسارة المبكرة الصغيرة، والنتيجة الأخرى الوحيدة هي أنه سيخسر الكثير متأخرا.
يقول الكاتب الأميركي توماس فريدمان في مقال له بصحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) إنه لا توجد خيارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا غير الخسارة، وأمامه إما أن يخسر مبكرا ويتعرض لقليل من المهانة، أو أن يخسر متأخرا ويتعرض لكثير من المهانة.
ويضيف أن بوتين لا يمكن أن ينتصر في أوكرانيا لأنها ببساطة ليست البلد الذي كان يعتقد أنها كانت بانتظار قطع رأس قيادتها “النازية” بسرعة حتى تسقط بلطف وتعود إلى حضن الأم، روسيا.
وقال إن بوتين استخف تماما برغبة أوكرانيا في الاستقلال والانضمام إلى الغرب، وقلل تماما من إرادة العديد من الأوكرانيين للقتال، حتى لو كان ذلك يعني الموت، من أجل هذين الهدفين، وبالغ في تقدير قواته المسلحة، وقلل تماما من قدرة الرئيس الأميركي جو بايدن على إقامة تحالف اقتصادي وعسكري عالمي لتمكين الأوكرانيين من الوقوف والقتال وتدمير روسيا من الداخل، كما استخف تماما بقدرة الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم على المشاركة في العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وتضخيمها، بعيدا عن أي شيء تبدأه الحكومات أو تفرضه عليها.
بوتين سيختار الخسارة المتأخرة
وأعرب فريدمان عن رعبه لأنه يرجح أن بوتين سيختار الخسارة المتأخرة التي ستؤدي إلى روسيا ضعيفة ومهانة ومخلة بالنظام، والتي يمكن أن تنقسم أو تتعرض لاضطراب قيادة داخلي طويل الأمد، مع فصائل مختلفة تتصارع على السلطة وبوجود كل تلك الرؤوس الحربية النووية، ومجرمي الإنترنت وآبار النفط والغاز.
كما أشار إلى الصدمات المالية والسياسية التي ستنطلق من روسيا، البلد الذي يعد ثالث أكبر منتج للنفط في العالم ويمتلك حوالي 6 آلاف رأس حربي نووي، عندما يخسر حربا من اختيار الرجل الواحد الذي كان يقودها ولا يستطيع الاعتراف بالهزيمة، لأنه يعرف بالتأكيد أن “التقاليد الوطنية الروسية لا ترحم النكسات العسكرية”، وفق ما لاحظه ليون آرون، الخبير الروسي في معهد “أميركان إنتربرايز” (American Enterprise)، الذي يكتب كتابا بعنوان “طريق بوتين إلى أوكرانيا”.
كل هزيمة لروسيا أدت لتغيير جذري
ولفت فريدمان الانتباه إلى أن آرون أوضح في صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) أن كل هزيمة كبرى لروسيا تقريبا أدت إلى تغيير جذري. فحرب القرم (1853-1856) عجلت بقيام ثورة الإمبراطور ألكسندر الثاني الليبرالية، وأدت الحرب الروسية اليابانية (1904-1905) إلى اندلاع الثورة الروسية الأولى، كما أدت كارثة الحرب العالمية الأولى إلى تنازل الإمبراطور نيكولاس الثاني عن العرش وقيام الثورة البلشفية، وأصبحت الحرب في أفغانستان عاملا رئيسيا في إصلاحات الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف “. كما ساهم الانسحاب من كوبا بشكل كبير في عزل نيكيتا خروتشوف بعد ذلك بعامين.
وفي الأسابيع المقبلة -يستمر الكاتب- سيتضح أكثر فأكثر أن أكبر مشاكل العالم مع بوتين في أوكرانيا هي أنه سيرفض الخسارة المبكرة الصغيرة، والنتيجة الأخرى الوحيدة هي أنه سيخسر الكثير متأخرا، ولكن لأن هذه هي حربه فقط ولا يمكنه الاعتراف بالهزيمة، فسيستمر في مضاعفة قوته في أوكرانيا حتى يفكر في استخدام سلاح نووي.
جرائم لم تشهدها أوروبا منذ هتلر
وقال إنه عندما يخطئ القائد في كثير من الأمور، فإن أفضل خيار له هو أن يخسر مبكرا وقليلا. وفي حالة بوتين، فإن ذلك يعني سحب قواته من أوكرانيا على الفور؛ وتقديم كذبة تحفظ ماء الوجه لتبرير “عمليته العسكرية الخاصة”، مثل الادعاء بأنها نجحت في حماية الروس الذين يعيشون في أوكرانيا؛ ووعد بمساعدة إخوة الروس على إعادة البناء.
لكن الإذلال الذي لا مفر منه، يقول الكاتب، سيكون بالتأكيد لا يطاق بالنسبة لهذا الرجل المهووس باستعادة الكرامة والوحدة لما يرى أنه الوطن الأم لروسيا.
وبالنظر إلى مقاومة الأوكرانيين في كل مكان للاحتلال الروسي، لكي “ينتصر” بوتين عسكريا على الأرض، سيحتاج جيشه إلى إخضاع كل مدينة رئيسية في أوكرانيا، ويشمل ذلك العاصمة كييف، وبعد أسابيع على الأرجح من حرب المدن والخسائر البشرية الهائلة في صفوف المدنيين. باختصار، لا يمكن فعل ذلك إلا من قبل بوتين وجنرالاته الذين يرتكبون جرائم حرب لم تشهدها أوروبا منذ عهد الزعيم النازي أدولف هتلر، الأمر الذي سيجعل روسيا بوتين دولة منبوذة دوليا بشكل دائم ومخيف.
المصدر : نيويورك تايمز
—————————–
يراهن بوتين على أن الغرب منحط لدرجة لا تسمح له بالدفاع عن قيمه. إنه مخطئ/ رافائيل بير
راهن لاديمير بوتين على حرب قصيرة لأنه لم يعتقد أن الأوكرانيين سيقاومون الغزو. وهو الآن يراهن على أن الروس سيتسامحون مع حرب طويلة وأن الغرب ، وسط شكوى صاخبة ، سيسمح له بإنهائها.
في المرحلة الأولى ، يتضمن ذلك استخدام كل سلاح تحت تصرف الكرملين بوحشية عشوائية حتى تتمكن الدبابات الروسية من التدحرج من خاركيف إلى الحدود البولندية.
من الممكن إخفاء رعب هذا الهجوم عن معظم الروس في معظم الأوقات ، ولكن ليس عنهم جميعًا إلى أجل غير مسمى. القصة التي ترويها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة هي عبارة عن محاكاة مروعة للواقع ، حيث تظهر طغمة أوكرانية من النازيين الجدد مدمنين على المخدرات تخدع المدنيين في خط النار. لقد طاردت الحقيقة من الهواء ، ووصفها القانون بأنها خاطئة. تقاسمها يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما .
لكن ختم الدعاية ليس محكمًا بما يكفي لمنع كل الدماء التي تُراق في أوكرانيا. الروس الذين يحصلون على معلوماتهم عبر الإنترنت هم أقل دعمًا لبوتين. يرقى هذا إلى حد الانقسام بين الأجيال ، على الرغم من أن الرئيس لا يزال لديه الكثير من المشجعين الأصغر سنًا. أفاد أصدقائي الروس بأسف أنه لا توجد زيادة في المطالبة بتغيير النظام تبدو وشيكة. يذهبون إلى المظاهرات ويهربون عندما تدخل شرطة مكافحة الشغب ويتحدثون عن الهجرة فور عودتهم بأمان إلى ديارهم. إنهم يحترقون بالعار الذي يلصقه بوتين ببلدهم.
أولئك الذين يفهمون ما بدأه الكرملين يعرفون أيضًا ما سيحدث بعد ذلك. يمكن الاستيلاء على أوكرانيا ولكن لا يمكن تهدئتها. وهذا يعني احتلالاً مطولاً لأمة لن تستسلم. إنه يعني حملة شرسة لمكافحة التمرد يتم فيها استدراج المجندين الروس المحبطين من قبل متطوعين أوكرانيين متحمسين للغاية. ادعاء بوتين بالأمس أنه لم يتم التخطيط لاستدعاء عام من قبل العديد من الآباء في جميع أنحاء روسيا على عكس ذلك: تحذير من أن أبنائهم المراهقين يتم اصطفافهم لأداء الواجب.
لم يخطط بوتين لمثل هذا النوع من الحرب وليس لديه فكرة عن كيفية إنهاءها. يعتقد محللون مستقلون أنه سيكون مستنقعًا كارثيًا للجيش الروسي. تقول تقارير موثوقة من موسكو أن هناك فصائل حول الكرملين توافق. وتقول المصادر نفسها إن بوتين عزل نفسه عن المعارضة. إنه يتمتع بدرجة عالية من الإمداد الأيديولوجي الخاص به. في هلوسته القومية ، كانت حدود ما بعد الاتحاد السوفيتي جروحًا تلحق بالوطن الأم السلافي من قبل الغرب الخبيث. إن مجزرة أوكرانيا هي عمل انتقامي تعويضي.
العدوان من هذا النوع لا تتأثر به الحجج الاقتصادية. لم يتوقع بوتين عقوبات بالحجم الذي تم فرضه ، أو لم يفهم الاحتمال الكامل. تخرج من المدرسة السوفيتية التي تتعامل مع الاقتصاد على أنه لعبة قوة محصلتها صفر بين الدول. الغرض من التجارة هو تأكيد القوة الوطنية واستغلال الضعف الأجنبي. الموارد الطبيعية هي الرافعات للتأثير الجغرافي الاستراتيجي ، حيث يتم تحويل الأرباح لتمويل أنماط حياة النخبة الكليبتوقراطية.
إن النموذج الاقتصادي القائم على سرقة الحكام من الجمهور لا يتوافق مع الديمقراطية. إن العقد غير المكتوب في روسيا ، الموروث من الحزب الشيوعي والذي لم يتم تحديثه كثيرًا ، هو أن عائدات الدولة والتدفقات المتدفقة من الفساد تشتري مستوى من الاستقرار. الدعاية والإكراه يقومان بالباقي. عندما تصبح الدولة أكثر فقراً ، يجب أن تكون الدعاية أكثر هستيرية ويجب أن تزداد يد الإكراه. هذا التأثير جار على قدم وساق.
يتوقع بوتين أن يؤدي القمع إلى إسكات أي استياء قد ينمو في ظل أزمة اقتصادية ناجمة عن العقوبات. سيتم تقديم التكلفة كدليل على العداء الغربي وفرصة لتطهير المجتمع من الخردة الأجنبية. يقول مشجعو الكرملين إن أرادت إيكيا المغادرة ، فلا بأس بذلك. من الأفضل شراء أثاث روسي أصيل.
هذه الرسالة لها جمهور متجاوب ، خاصة بين كبار السن من الروس. لم يتضح بعد كيف سيحدث مع الجيل الرقمي. هجرة العقول أمر لا مفر منه. ينعكس الخوف الرسمي من ذلك في مرسوم التنازل عن الضرائب لشركات التكنولوجيا وإعفاء المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من الخدمة العسكرية. إن روسيا التي تتحدث لغة التعامل العقلاني مع الغرب تتجه إلى المنفى.
بعد أن صمد أمام الضربة الفورية من العقوبات ، يتوقع بوتين الآن أن ينتعش الألم الاقتصادي إلى الغرب. تؤجج الحرب أسعار الطاقة وتغذي التضخم. سيؤثر تعطيل صادرات الحبوب الأوكرانية على الإمدادات الغذائية. إذا لم تتمكن الشركات الروسية من خدمة الديون ، فإن الدائنين الغربيين سيتضررون.
الرهان الأساسي هو أن الحكومات الديمقراطية تعوقها حاجتها إلى إرضاء المستهلكين الذين نفد صبرهم. سوف تستنفد الرغبة في الإبقاء على العقوبات بسبب الشهية للنفط والغاز. هذا امتداد لوجهة النظر البوتينية القائلة بأن الليبرالية عقيدة منحلة. إنه يقلب الناس مترهلين ، ويطعمهم المخدرات ، ويضعف الرجولة الوطنية بفخر المثليين وانتهاكات أخرى للأخلاق التقليدية. من المتوقع أن تغلق مثل هذه المجتمعات أولاً في حرب الاستنزاف الاقتصادي عندما تتعارض مع رجولة روسيا وقدرتها التي تم التباهي بها تاريخيًا على الرواقية والتضحية بالنفس.
ليس بوتين هو أول طاغية يفكر بهذه الطريقة. هذه العقيدة مبتذلة كما هو متوقع من رجل متوسط الأداء في المخابرات السوفياتية يبلغ من العمر 69 عامًا والذي تم حمله إلى السلطة على أكتاف رجال العصابات ثم قضى وقتًا طويلاً في التشمس في الأساطير عن نفسه لدرجة أنه نسي أنها كانت أكاذيب ساخرة.
يستخف الحكام الديكتاتوريون بقوة الديمقراطيات لأنهم لا يرون سوى ضعف القادة الذين يعرضون أنفسهم لخطر تغيير النظام في انتخابات حرة. إنهم يرون المعارضة القوية والصحافة الحرة على أنها نقاط ضعف للنظام ، مما يجعل من الصعب السيطرة عليها من الأعلى. إنهم لا يدركون أن هذه هي الصفات الكامنة وراء المرونة والقدرة على التكيف التي جعلت الديمقراطية الليبرالية النموذج الأكثر نجاحًا لتنظيم المجتمع في تاريخ الحضارة الإنسانية.
هناك سبب وراء مغادرة الروس الشبان المتعلمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الحقيقة. إنهم يعرفون ما يحدث في النهاية عندما يراهن ديكتاتور كل شيء على أن المستقبل ينتمي إلى الوهم القومي العسكري. إنه رهان يخسره بوتين. إنه يخسر بشكل أسرع إذا كان مخطئًا بشأن استعداد المواطنين في الديمقراطيات الحرة لتقديم التضحيات وتحمل بعض الآلام الاقتصادية لمساعدة جيرانهم والدفاع عن أسلوب حياتهم. أعتقد أنه خطأ. أتمنى أن يكون مخطئا.
رافائيل بير كاتب عمود في صحيفة الغارديان
——————————-
بوتين يهدد العالم.. الحرب في أوكرانيا قد تنزلق لسيناريوهات سيئة
منذ خطاب إعلان الحرب على أوكرانيا والمسؤولون الروس، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، يشيرون مرارا وتكرارا إلى احتمال الرد النووي في حال تدخلت الولايات المتحدة أو شركاؤها في حلف شمال الأطلسي في الحرب.
ومؤخرا أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى هذا الموضوع قائلا إن حربا عالمية ثالثة ستكون حربا نووية وحث القادة الغربيين على النظر في ما قد تنطوي عليه “حرب حقيقية” مع روسيا.
صدمة “نووية”
وقال تحليل لموقع Foreign Affairs الأميركي إن مجرد فكرة العودة إلى الحافة النووية التي كان عليها العالم في الحرب الباردة هو أمر صادم لكثير من المراقبين.
وأجلت الولايات المتحدة تجربة صاروخ باليستي في بداية مارس لعدم الدفع بالتوتر إلى الأمام بحسب مسؤولين أميركيين.
ويقول الموقع إن التركيز الشديد على التصعيد النووي يحجب مشكلة لا تقل أهمية، خطر التصعيد التقليدي – أي حرب غير نووية بين الناتو وروسيا.
ويضيف تقرير فورين أفيرز أن الأسابيع المقبلة من المرجح أن تكون أكثر خطورة، مضيفا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون متناغمة بشكل خاص مع مخاطر التصعيد مع بدء المرحلة التالية من الصراع، ويجب أن تضاعف من إيجاد طرق لإنهاء الصراع في أوكرانيا عندما تسنح لها الفرصة.
وأشار إلى أنه “قد ينطوي ذلك على خيارات صعبة وغير سارة، مثل رفع بعض أسوأ العقوبات المفروضة على روسيا مقابل إنهاء الأعمال العدائية، ومع ذلك، سيكون أكثر فعالية في تجنب كارثة أسوأ من أي من الخيارات الأخرى المتاحة”.
ويقول الموقع إن التجارب العالمية عبر التاريخ بدأت بتصعيد عسكري بسيط في البداية.
ويضيف أن الولايات المتحدة وروسيا اتخذتا بالفعل خطوات لتعزيز شعورهما بعدم الأمان، مما دفع الطرف الآخر إلى أن يفعل الشيء نفسه.
ويستشهد الموقع بتاريخ من التصعيد بين واشنطن وموسكو يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويمتد إلى الحرب الحالية مع أوكرانيا.
ويضيف أنه على الرغم من هذا، كان موسكو أكثر وضوحا بالتعبير عن استعدادها للتصعيد من الغرب الذي أكد أنه لن يتدخل بشكل مباشر في الحرب على أوكرانيا.
ويقول الموقع إنه بالنظر إلى أن صراعات بالأسلحة التقليدية حدثت بين القوى النووية في أماكن أخرى، بما في ذلك الاشتباكات بين الصين والاتحاد السوفيتي في الستينات وحرب الهند وباكستان في نهاية التسعينات، فإن صراعا غير نووي ممكن الحدوث الآن.
صراعات “تقليدية” خطرة
ويحذر الموقع من أن الضرر الاقتصادي في روسيا شديدا إذا أصبح بما فيه الكفاية، فقد يقرر بوتين أن الأمر يستحق الانتقام من خلال وسائل غير عسكرية مثل الهجمات الإلكترونية، وقد يقرر أن الأمور سيئة بما فيه الكفاية لدرجة أن الأمر يستحق التخلي عن عائدات الطاقة وإغلاق بعض خطوط أنابيب الغاز إلى أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ويقول إن من المفترض أن تأمل روسيا في استخدام هذه الخطوات لكسب نفوذ على السياسة الغربية، لكنها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بسهولة فالهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى إجراء مشاورات بموجب المادة 5 من المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي، والتي تنص على أن الهجوم ضد دولة عضو واحدة سيعتبر هجوما ضدهم جميعا.
وقد يؤدي ذلك إلى هجمات إلكترونية انتقامية على روسيا تتصاعد إلى حرب مباشرة.
ويضيف أن هناك أيضا خطر العمل المنفرد من قبل الحلفاء الإقليميين، الأمر الذي قد يجر روسيا وبقية أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر.
ويضيف أن الدول الأعضاء في الناتو الأقرب إلى روسيا – وخاصة بولندا ودول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) –كانت من بين أكثر المؤيدين المتحمسين والنشطين لتسليح أوكرانيا.
ويتساءل الموقع ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا قصفت روسيا معسكرا أوكرانيا أو بعثة إعادة تموين على الأراضي البولندية على سبيل المثال؟
أو ماذا لو قتل عناصر من القوات الليتوانية ثناء تسليم الأسلحة للقوات الأوكرانية؟
ويخلص الموقع إلى المخاطر كبيرة للغاية بحيث لا تستطيع الدول المسلحة نوويا اتخاذ قرار بالحرب مع بعضها، ومع ذلك، فإن دوامات انعدام الأمن لها منطقها الخاص، ويجب على واشنطن أن تصغي إلى دروس التاريخ.
الحرة
——————————–
===================




