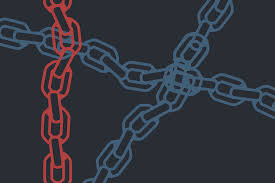جيل البطون الفارغة لمستقبل سورية/ سوسن جميل حسن

عن أيّ السّيَر يمكن أن نحكي في سورية؟ سيرة الوجع؟ سيرة الفقر؟ سيرة الجوع؟ سيرة انتهاك الحياة؟ سيرة انتهاك الكرامة؟ سيرة التهجير؟ سيرة التقسيم؟ سيرة الإحلال الثقافي؟ سير باتت لا تعدّ، إنّما هناك سير مواربة، مختبئة، أو على الأصحّ، تنمو في رحم مظلم تغلّفه كل تلك السير، إنها الأجيال التي تولد وتكبر في ظلّ هذا الانعدام المتكامل لمقوّمات الحياة، بل يمكن القول إنها سيرة العدم وهو يتفشّى في نسغ الحياة.
طوينا أحد عشر عامًا، ونحن ماضون في العام الثاني عشر، من دون أمل يلوح في الأفق، كبر أطفال، وولد آخرون، وهؤلاء يُفترض أنهم جيل المستقبل، بينما الحياة تتردّى وتصبح شحيحةً كل عام أكثر، في سورية المقسّمة، وفي مخيّمات النزوح واللجوء. وفي الوقت ذاته، تزداد مشكلات العالم وأزماته، تجتمع الدول الكبرى والفاعلة لتدرس الواقع وتقترح الحلول التي لسنا في صلب اهتماماتها، بينما واقعنا ينزلق باضطراد نحو قاعٍ من البؤس والجحيم.
يشير سوء التغذية إلى النقص أو الزيادة أو عدم التوازن في مدخول الطاقة و/ أو المغذّيات لدى الشخص. ويشمل مصطلح سوء التغذية ثلاث مجموعات واسعة النطاق من الحالات الصحية: نقص التغذية، وسوء التغذية، وفرط الوزن أو السمنة. فإذا كان السائد لدى غالبية أطفال سورية، قبل الأعوام الحارقة هذه، هو سوء التغذية، بسبب أن الفقر، بشكل عام، لم يكن يمتلك أنيابًا ويعضّ حينها، فالغالبية من الشعب كان بإمكانها أن “تأكل”، إنما نسبة من يحصلون على الراتب الغذائي المطلوب لبناء أجسام سليمة وعقول حيويّة، فهي ليست مرتفعة حكمًا.
أمّا اليوم فإن نقص التغذية، بل ندرتها هي الوحش المتربّص بحياة السوريين وأجسامهم، خصوصا الأطفال، في ظل انعدام الأمن الغذائي تقريبًا، حيث تعود مشكلة الرغيف، الذي يُعدّ آخر عنصر للبقاء على الحياة، إلى أكثر من عامين مضيا، ولم تكن وقتها الحرب الروسية الأوكرانية قد نشبت، كذلك لم يكن وباء كوفيد قد شلّ الاقتصاد العالمي، لكن لسورية ظروفها الخاصة التي جعلت البلاد تتهاوى على وقع حربٍ مدمّرة، فأصابت البشر والشجر والحجر، وأدّت إلى دولةٍ فاشلةٍ عاجزة عن وضع الحلول للأزمات المتلاحقة، بينما الشعب يعاني، وينزلق من سيّئ إلى أسوأ.
يعاني السوريون أينما وجدوا ضمن الجغرافية التي كانت تسمّى سورية قبل الحرب، وصارت بعدها مقسّمة إلى أربع مناطق، منطقة النظام وهي أكبرها مساحة وكثافة، ومنطقة الإدارة الذاتية، ومنطقة الحكومة المؤقتة، ومنطقة حكومة الإنقاذ. وكان بالإمكان أن نتجنّب هذا المصير، لولا ابتلاؤنا بأنظمة قمعية مستبدّة، سياسية واجتماعية ودينية، شلّت التفكير عقودا، كانت أولى نتائجه الكارثية ضحالة الانتماء إلى وطن جامع، وعدم القدرة على إنجاز التغيير المنشود، إذ أدّى العنف الذي مورس بحق الشعب الذي صرخ من اختناقه وبحثه عن حريته وكرامته إلى استيلاد عنفٍ مقابل، أوصل البلاد إلى واقعنا الراهن.
المخيف، فيما وصلنا إليه، هو نقص التغذية المريع والمتسارع، والذي ينجم عنه الهزال والتقزّم ونقص الوزن وعوز الفيتامينات والمعادن، وما ينعكس بسببها على مناعة الجسم ومقاومته الأمراض من جهة، وعلى الأداء الذهني والتطوّر الروحي والحركي من جهة أخرى، عدا اضمحلال الحجوم المفترضة للبالغين مستقبلًا، وما ينجم عنه أيضًا من تأثيراتٍ على العمل والقيام بأنشطة حياتية عديدة، فالتقزّم هو نقص الطول بالنسبة إلى المرحلة العمرية، وهو مرتبط بتردّي الحالتين الاقتصادية والاجتماعية، الذي يصيب الأمهات قبل أطفالهنّ، فالتأسيس لجسم متين يبدأ من الحياة الجنينية ويستمر حتى نهاية العام الثاني، هذه المرحلة حسّاسة جدًّا وتأسيسيّة، وهي تُنتهك في سورية، التي أصبحت الغالبية الساحقة من سكانها مصابة بالفقر المدقع، يعانون من المجاعة ونقص التغذية، حتى صار رغيف الخبز أهمّ قضية حياتية يناضل السوريون من أجلها، الرغيف الذي يُخمد معركة البطون الشرسة، من دون أن يمدّ الدماغ بما يحتاج ليزدهر ويبدع، ومن دون أن يؤمّن للجسم ما يحتاج من أجل البناء والأداء.
يُقال إن أصل زراعة القمح يعود إلى سورية وفلسطين، ومن هناك انطلق إلى أنحاء العالم تاريخيًّا، وإن القمح السوري، خصوصا القاسي منه، من أفضل الأنواع في العالم، لكن بماذا يفيد هذا الكلام حاليًّا؟ إنه يشبه الكلام الممجوج عن ماضينا التليد، وتاريخنا العامر بالأمجاد والبطولات، بينما الواقع في انحدار مريع نحو دركٍ ما زال يزداد عمقًا كلما اقتربنا منه، إنها رحلة التراجع المتناقضة مع خط الحياة الذي يسير إلى الأمام دائمًا، ويشبه الخطابات السياسية الخشبية التي تراوغ الواقع، وتعمل على تضليل ما بقي من ضمائر وعقول، وتعميتها عن مصيرها الأسود.
أصدر “برنامج الغذاء العالمي” التابع للأمم المتحدة تحذيرات طارئة من أن 14 بلداً، تقع أساساً في أفريقيا والشرق الأوسط، ستواجه ظروفَ المجاعة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية من أجل توفير إمدادات الغذاء خلال الأشهر المقبلة. لا أدري في الواقع إلى ماذا استند التقرير ليحدّد الأزمة بـ”الأشهر المقبلة”، في وقت تشير معطيات كثيرة إلى مستقبل ضبابي ومقلق بالنسبة إلى البشرية، خصوصًا في ظل الأوبئة التي تظهر وتجتاح العالم، كما في ظل التغيرات المناخية الكارثية، بالإضافة إلى الصراعات والحروب، من دون أن نغفل التغيّرات التي طرأت على حياة البشر، لدى شعوب عديدة مرفّهة، والجنوح نحو الاستهلاك بلا أي ضوابط أو تفكير بالغير، كذلك الهدر اللاواعي لدى الشعوب الأخرى، النامية وما دونها، في ظل العولمة والسطو الثقافي الذي ساند الاقتصاد وساعده على توسيع أسواقه. فإذا كان لدى القوى الكبرى من الأساسات ما يكفي للبناء عليها وتدارك مشكلاتها، فإن دول العالم الآخر لن تكون في أولوياتها، إلّا في ما يتعلّق بأمنها وأمن حدودها والبحث عن حلول لمنع القادمين إليها من جحيم أوطانها، بينما المطلوب من أجل مستقبل البشرية أن تكون هناك عدالة بين البشر، وهذا لن يتحقق في ظل التغوّل الشديد لرأس المال والشركات التي هي من يصنع السياسات، وكما قال أنّند جيريدهارداس، كاتب المقالات السابق في صحيفة نيويورك تايمز، فإن طبقة النخبة الثرية لا تترك بقية العالم وراءها فحسب، بل تزدهر بدقة من خلال الدوس على أعناق الجميع.
أمّا الأخطر في سورية، التي كانت أول دولة عربية حققت الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الاستراتيجية فيما مضى، وتفتقر إليه اليوم، فلديها نخبة فاسدين من رجال السلطة وتجار الحرب تدوس على أعناق الواقعين تحت سطوتها، وتمنعهم من الأنين والتوجّع، وبالتالي، فإن وضع خطط من أجل استثمار موارد البيئة المتعدّدة، واستثمار الموارد البشرية والسعي إلى تأمين أساسيات الحياة للواقعين تحت سيطرتها، في منطقة النظام وغيرها، ليس في سلّم الأولويّات، بل سعت جميعها إلى محاولة شراء القمح بأسعارٍ لا تُعوِّض على المزارعين كلفة المحصول. وزيادة عليها، جاء ارتفاع سعر المحروقات ليزيد في الأمر سوءًا، بينما، لو كانت هذه الحكومات تضع المواطنين هدفها الأهم، لكان من أولوياتها دعم الإنتاج المحلّي، وحماية المواسم التي تتعرّض للحرق كل عام، فأزمة الجوع تتفشّى في العالم، وهناك الملايين المهدّدون به في الغد القريب، لا بدّ من العودة إلى استثمار الموارد المحلّية، لكن الأولوية في سورية كانت للمعارك والسلاح والحرب التي تستنزف وتأتي على الأخضر واليابس، وتوزّع الكلفة على أفراد الشعب المُفقر والجائع.
الدولة هي المسؤولة الأولى عن حياة مواطنيها، فماذا تفعل، إن كانت ما زالت تعتبر نفسها دولة تملك مقوّمات البقاء، من أجل هذه الحياة التي تَتوعّد بأجيال تتقزّم بالتدريج، وتزداد معاناتها وتتوسّع، من فقر الدم إلى فقر المخيّلة؟ أي وطنٍ سيبنون؟ وأي وعد تستطيع أنظمة من هذا النوع أن تعد شعوبها به؟ كلّ يوم زيادة في عمر هذه الأزمة الجسيمة والمحنة الكبيرة، سوف ينقص من أعمار جيل المستقبل، ومن كفاءته، ومن قدرته على الإبداع والبناء.
العربي الجديد