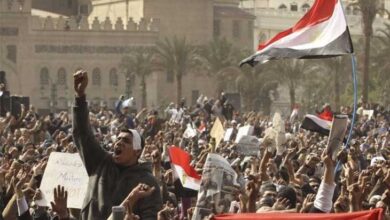عن حسن حنفي و”تنويره الإسلامي” ونقده للتنوير الأوروبي: الأصالة بوصفها أصولية، والتجديد بوصفه “تقديمًا/ حسام الدين درويش

يندرج تناول حسن حنفي لفكر التنوير، في التوجّه الانتقاديّ ذاته الذي رأيناه عند الأفغانيّ، لكنّه يختلف عنه، من حيث إنّ انتقادّه موجّهٌ أساسًا نحو الأحكام المسبقة لعصر التنوير، ونحو ما أسماه ﺑ “القصور الذاتيّ لفلسفة التنوير”، وهو القصور المتمثّل في أنّ لهذه الفلسفة حدودًا “لم تتجاوزها، قد تكون هي السبب في عدم رسوخها في الوعي الأوربيّ، وعدم تأثيرها في سلوكه.” فحنفي يشيد، من حيث المبدأ، بقيم التنوير، ويعدّ فلسفة التنوير “من أزهر ما أنتجه الوعي الأوروبيّ من فلسفاتٍ بل أنها أزهرها على الإطلاق.” لكنّه، في المقابل، ينتقد “الوعي الأوربيّ الذي عجز برأيه عن تمثّل هذه القيم والحفاظ عليها وتعميقها نظريًّا، وعن ممارستها وتجسيدها عمليًّا، بحيث أفضى تطوّر هذه القيم، في هذا الوعي، إلى نقيض هذه القيم ونقضها. وتتمثّل قيم التنوير عند حنفي في “العقل، والتقدّم والإنسان الشامل أو العالميّ، والتنوير العقليّ، والفرديّة، والأمّة، والشمول أو العالميّة.
ويرى حنفي أنّ “العقل الغربيّ” قد سقط في هاوية اللامعقول، أو انتهى إليه، متخليًّا عن “العقل التنويريّ”. أمّا الحرّيّة التي كانت في فلسفة التنوير “حريّةً هادفةً تبغي خلاص الإنسان من كلّ صور القهر والطغيان الدينيّ أو السياسيّ”، فقد “انتهت بعد فلسفة التنوير إلى كونها تعبيرًا عن إرادةٍ لاعاقلةٍ، […]. فلم تعد حريّةً هادفةً بل أصبحت حريّةً عابثةً تعبّر عن أزمة الوجدان أكثر مما تعبّر عن غائيّته.” أمّا التقدّم فقد ظلّ حبيس “التنوير العقليّ لا التغيّر الاجتماعيّ”، إذ حاول فلاسفة التنوير دفعه “على كلّ المستويات”، العقليّة والعلميّة والحضاريّة والاجتماعيّة، لكنّ قوّة الدفع هذه تلاشت لاحقًا، ولم تستطع هذه القوة »تحريك الوعي الأوربيّ إلا بضع خطواتٍ«، وانتهى “التقدّم والثورة إلى سكونٍ ونظامٍ على يد الأيديولوجيّين وأوجست كونت.” وعلى الرّغم من أنّ القرن الثامن عشر جعل الاستنارة العقليّة تشمل الواقع الاجتماعيّ، إلا أنّها ظلّت منفصلةً عن هذا الواقع، ولم تتحوّل إلى ثورةٍ اجتماعيّةٍ بالفعل – باستثناء الثورة الفرنسيّة – إلا في القرن التاسع عشر.
وعلى صعيد مفهوم الإنسان، انتقل الوعي الأوروبيّ من مفهوم “الإنسان الشامل العاقل الحر” إلى مفهومٍ عنصريٍّ أو مركزيٍّ ضيّقٍ يتمحور حول الإنسان الأوروبيّ أو الغربيّ الأبيض أو المسيحيّ. وبذلك “فقد الوعي الأوربيّ في حكمه على التاريخ حياده، ولم يستطع تجاوز حدوده، ومن ثم فلم يعد يمثّل إلا نفسه.” أمّا الفرديّة التي أصبحت “إحدى مكاسب الليبراليّة منذ القرن السابع عشر”، وكانت، في فلسفة التنوير، “أكبر ردّ فعلٍ على قهر الفرد قبل العصور الحديثة في المؤسّسات الدينيّة أو عند أمراء الإقطاع وكبار الملّاك”، فلم يصحبها، في فلسفة التنوير، بعدٌ اجتماعيٌّ واضحٌ؛ “فلو أنّ هذا البعد الاجتماعيّ كان حاضرًا في فلسفة التنوير حضوراً أساسيًّا لربما أمكن استمرارها ولظهرت فاعليّتها في الواقع، وبدا أثرها على الجماهير؛ ولتغلغلت في الشعور التاريخيّ بدلاً من أن تظلّ مجرّد افتراضٍ نظريٍّ في الدوائر الثقافيّة ولا تتجاوز سطح الأشياء.” أمّا مفهوم “الأمّة” فقد كان، في فلسفة التنوير، ذا طابعٍ إنسانيٍّ شاملٍ أو عالميٍّ، إذ كان يحيل على الإنسان “المواطن” ويعبّر عن “ولائه للأمّة والأرض”، “لكن ولسوء الحظّ سرعان ما تحوّل مفهوم الأمّة إلى الأمّة القوميّة أي الأمّة المتميّزة على غيرها بتاريخٍ ودينٍ ولغةٍ وتراثٍ وحضارةٍ على أحسن الفروض، وبجنسٍ وعرفٍ وهباتٍ فطريّةٍ على أسوأ الفروض.” وأدّى ذلك إلى تكوين “أيديولوجيّاتٍ عنصريّةٍ” و”حروبٍ عالميّةٍ” “وظلّ الوعيّ الاوربيّ قاصرًا على تجاوز حدوده، وعاجزًا عن الوصول إلى ما هو أبعد من قوميّاته المتطاحنة.” وهكذا تمّ التحوّل، في الوعيّ الأوربيّ، من الشمول والعالميّة، التي ترتفع فوق خصوصيّة العقائد أو الطبقة أو المذهب، إلى خصوصيّاتٍ قوميّةٍ أو عنصريّةٍ متمركزةٍ حول ذاتها الضيّقة.
من الواضح أنّ نقد حنفي أو انتقاده منصبٌّ، تحديدًا وعمومًا، على الوعي الأوربّيّ أو الغربيّ أكثر من كونه يستهدف فلسفة التنوير وقيمها. ولهذا كان من الأنسب الحديث عن “أوجه القصور في الوعي الأوروبيّ” – وهي الأوجه التي ظهرت عمومًا بعد عصر التنوير – بدلًا من الحديث عن “أوجّه القصور في فلسفة التنوير”. لكنّنا نرى في هذا الانتقاد اختزالًا مزدوجًا في رؤيّةٍ أحاديّةٍ تبسيطيّةٍ لا تتناسب مع تعقيد الموضوع المبحوث. يكمن الاختزال الأوّل في القطيعة التي يقيمها بين الوعيّ الفلسفيّ الأوروبيّ التنويريّ والوعي الأوروبيّ اللاحق، ووضعه للوعيّين في حالة تناقضٍ لا مجال للتشابك أو التصالح بينهما. ويترافق هذا التوصيف للوعيين مع تقييمٍ إيجابيٍّ، دائمٍ تقريبًا، للوعي الأوّل وتقييمٍ سلبيٍّ، دائمٍ تقريبًا، للوعي الثاني.
ففيما يخصّ العقل، لا نعتقد أنّه من المناسب أو المعقول اختزال فلسفة التنوير إلى فلسفةٍ للعقل وللعقلانيّة النقديّة، واختزال الوعي الأوروبيّ اللاحق إلى وعيٍ يسود فيه اللامعقول، بشكلٍ كاملٍ، لدرجةٍ يمكن معها القول: “خرج العقل من الإنسان وظهر في الآلة […]، فلم يعد للعقل وظيفة، وتخلّى عن عرشه إمّا للتصوّف أو للآلة.” فالتنوير والعقل النقديّ كانا ومازالا حاضرين في الوعيّ الأوروبيّ، النخبويّ وغير النخبويّ؛ وفلسفة ماركوزه – الذي يستشهد به حنفي نفسه – تنتمي إلى تيارٍ فلسفيٍّ عقلانيٍّ كان له حضورٌ قويٍّ في القرن العشرين (مدرسة فرانكفورت الاجتماعيّة النقديّة). وقد مارس هذا التيار وغيره وظيفة الرفض والنقد والسلب، بقدر انتقاده عدم تفعيل هذه الوظيفة في عالمنا المعاصر. فالحداثة، بتنويرها وعقلانيّتها النقديّة، حاضرةٌ، في قلب عالم ما بعد الحداثة. وبهذا المعنى يمكن أن نفهم أطروحة هابّرماس – أحد ممثلي العقلانيّة النقديّة المعاصرة – بخصوص الراهنيّة المستمرة للحداثة وعدم اكتمالها حتّى الآن. فعالم أو فكر ما بعد الحداثة تجاوز عالم أو فكر الحداثة، بالمعنى الهيغليّ للتجاوز، وهو المعنى الذي يعني التضمّن والاستيعاب والانتقال إلى مرحلةٍ جديدةٍ “مختلفةٍ” أو “أرقى”، في الصيرورة التاريخيّة. وفي المقابل، لم يكن الوعي التنويريّ عقلًا محضًا، إذ تضمّن مسبقًا إرهاصات الوعي الذي سيتجاوزه لاحقًا. وبدا ذلك واضحًا، خصوصًا وتحديدًا، في فلسفة روسّو التي تنتمي إلى وعي ما بعد الحداثة بقدر انتمائها إلى وعي الحداثة التنويريّة، وربما أكثر. فعلى الرّغم من النزعة العقلانيّة السائدة في بعض أعمال روسّو (في العقد الاجتماعيّ خصوصًا)، إلا أنّ هذه الفلسفة تتضمّن أيضًا (في الخطابين الأوّل والثاني خصوصّا) نقدًا شديدًا وجذريّا للعقل وللعقلانيّة التنويريّة السائدة آنذاك.
وبالنسبة إلى الحريّة، ليس صحيحًا التعميم القائل إنّ حرّيّة فلسفة التنوير كانت “تبغي خلاص الإنسان من كلّ صور القهر والطغيان الدينيّ أو السياسيّ”. فالكثير من فلاسفة عصر التنوير – ومنهم روسّو – لم يكونوا يقولون بحرّيّة الاعتقاد، بشكلٍ كاملٍ، إذ شدّد فولتير على الأهمّيّة الكبيرة للإيمان بالله، بالنسبة إلى الأخلاق والنظام الاجتماعيّ، وذهب روسّو إلى حدّ القول: “لا يمكن للمرء أن يكون لا مواطنًا صالحًا ولا رعيّةً من الرعايا المخلصين”، ما لم يقرّ ﺑ »إعلان إيمانٍ مدنيٍّ خالصٍ يعود لصاحب السيادة أن يضبطَ بنوده لا على جهة أنّها، بالتدقيق، عقائد دينيّةٌ، بل على أنّها شعورٌ بالألفة الاجتماعيّة.« وعلى صعيد الحرّيّات السياسيّة، لم يكن فلاسفة التنوير الفرنسيّ عمومًا – باستثناء روسّو فقط – شديدي الإيمان بالديمقراطيّة، »فقليلٌ فقط من الناس كانوا في ذلك الوقت يؤمنون بالديمقراطيّة.” وفي مقابل ذلك، نجد أنّ العالم الأوروبيّ، في ما بعد عصر التنوير، أصبح يؤمن بشكلٍ متزايدٍ بالحريّات الدينيّة والسياسيّة. ولا يمكن اختزال هذه الحرّيّات المتزايدة، كمًّا وكيفًا، إلى مجرّد “حرّيّةٍ عابثةٍ”، كما فعل حنفي.
أمّا بالنسبة إلى فكرة التقدّم، فقد كان نقدها وانتقادها الشديدين حاضرين في عصر التنوير الذي رفع معظم فلاسفته لواء هذه الفكرة. وتتضمّن فلسفة روسّو – في الخطابين الأوّل والثاني خصوصًا – أقوى أشكال ومضامين هذا النقد أو الانتقاد. كما أنّ هذه الفلسفة دليلٌ على أنّ عصر التنوير كان يتضمّن استهدافًا للتغيّر والتغيير الاجتماعيّين، ولم تكن أهدافه تقتصر على التنوير العقليّ. وقد استمّرت هذه الدعوة إلى التغيّر الاجتماعي، في القرنين اللاحقين، من خلال الفلسفات “اليساريّة” عمومًا، والفلسفة الماركسيّة، خصوصًا. وما زالت دعاوى التغيير والثورة حاضرةً، لدرجة أو لأخرى، في الوعي والواقع الغربيّين. وربما كان من الصعب القول إنّ القرن العشرين كان قرن ثوراتٍ اجتماعيّةٍ أو سياسيّةٍ في أوروبا، لكن، في المقابل، من الصعب أكثر القول إنّ ذلك القرن كان قرن “سكونٍ ونظامٍ” فقط. فتغيّراتٌ كثيرةٌ وكبيرةٌ حصلت في أوربا القرن العشرين، وإن لم تتّخذ هذه التغييرات طابع الثورات غالبًا.
ولن نستفيض في مناقشة بقيّة الانتقادات، لأنّ منطق ردودنا السابقة، وبعض مضامينها، يمكن أن يتكرّر في مناقشة فكرتي “الإنسان” و”الاستنارة العقليّة” و”الشمول”. لكنّنا نعتقد أنّ فكرة “الفرديّة” تستحقّ اهتمامًا خاصًّا. فنحن نعتقد أنّ البعد الاجتماعيّ الواضح لم يكن غائباً عن فكرة الفرديّة في عصر التنوير. ومن اللافت للانتباه أنّ حنفي يستحضر فكرة “الإنسان الطبيعيّ” عند روسّو، للإشارة إلى هذا الغياب. لهذا كان من الضروريّ، في هذا السياق، التذكير بأنّ مفهوم “الإنسان الطبيعيّ”، عند روسّو، يحيل على نموذجٍ نظريٍّ افتراضيٍ، أكثر مما يحيل على واقعةٍ تاريخيّةٍ. وغياب البعد الاجتماعيّ عن نموذج “الإنسان الطبيعيّ، يقابله محايَثة هذا البعد، في فلسفة روسّو نفسها، للإنسان في المجتمع. فطبيعة الإنسان في المجتمع هي طبيعةٌ اجتماعيّةٌ بامتيازٍ، من وجهة نظر روسّو. ويتضّح البعد الاجتماعيّ للفرد، إذا أخذنا في الحسبان مدى أهمّيّة أو حيويّة اعتراف الآخر، بالنسبة إلى كلّ إنسانٍ في المجتمع. ويتضّح هذا البعد أكثر، عندما نتذكّر أفكار روسّو عن “الإرادة العامّة”، المختلفة عن إرادة الجميع أو المجموع، و”الخير العامّ” و”المصلحة العامّة”. ففي عقد روسّو الاجتماعيّ يصبح للمجتمع أهميّةً بحدّ ذاته، لا يمكن ردّها إلى مجموع أهميّات الأفراد. وفي حديثه عن “الأمّة”، الذي يلي حديثه عن “الفرديّة”، يشير حنفي نفسه إلى هذه النقطة حين يقول: “أصبح انتساب المرء إلى جماعةٍ إحدى أبعاده الإنسانيّة. […] وظهرت مفاهيم المجتمع المدني والقانون الوضعيّ والنظام الاجتماعيّ لتؤكّد على هذا الجانب الجماعي في الإنسان.” والجدير بالذكر أنّ تيار الجماعاتيّين والقائلين بفلسفة الاعتراف، في الفلسفة المعاصرة، يشدّد على أهميّة البعد الاجتماعيّ للأفراد، لتجاوز التركيز المبالغ فيه على الفرديّة، لدى الليبراليّة التقليديّة أو المتطرفة. وكما ذكرنا سابقًا، يستند تايلور – وهو أحد المنتمين إلى الجماعاتيّين والمنظّرين لفلسفة الاعتراف المعاصرة – إلى روسّو وفيشته وهيغل، في إبرازه للأهمّيّة الكبيرة للبعد الاجتماعيّ والبينذواتيّ للفرد. لهذا لا ينبغي القول بغياب كاملٍ للبعد الاجتماعيّ عن مفهوم الفرد، سواءٌ تعلّق الأمر بفلسفة التنوير أم بالفلسفة المعاصرة.
ويكمن الاختزال الثاني، الذي يقوم به حنفيّ، في ردّ التنوير وقيمه إلى أصلٍ واحدٍ ناجزٍ وكاملٍ يتمثّل في “الإسلام أو في “التراث الاعتزاليّ وروح الاسلام”. ووفقًا لهذا الاختزال، فإنّ »فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر ودعوتها إلى العقل والحرّيّة والتقدّم والمساواة دعوةٌ إسلاميّةٌ خالصةٌ”؛ ويكون الإسلام “نموذجًا”، بل النموذج، لفلسفة التنوير؛ ولو كان فلاسفة التنوير عالِمين بهذا الإسلام ومطّلعين عليه وعلى التيّار الاعتزاليّ، لتجنّبوا الأحكام المسبقة التي صنعت “القصور الذاتيّ لفلسفة التنوير”. ويبدو واضحًا التوجّه “السلفيّ” و”الأصوليّ” في فكر حنفي، فالأسلاف (الإسلام والتيار الاعتزاليّ خصوصًا) لم يتركوا مجالاً للأخلاف، لكي يضيفوا شيئًا جديدًا. ولقيم الحقيقة والخير، ولقيم التنوير جميعًا، أصلٌ ناجزٌ ومكتملٌ، ﻓ »ما أعلن لسنج اكتماله في القرن الثامن عشر قد أعلن الإسلام تحقيقه في القرن السابع من قبل باكتمال الوحي، وإعلان استقلال الإنسان عقلًا وإرادةً، وتأسيس مجتمع العدل والمساواة.” ﻓ “الانحراف نحو الغرب واغتراب شعورنا القوميّ” “هو السبب في إغراء فلسفة التنوير للمثقّفين العرب وللمصلحين الدينيّين، وهم لا يعلمون أنها تحاول اكتشاف ما وضعه الإسلام قبل ذلك بأحد عشر قرنًا، وما صاغه المعتزلة بثمانية قرونٍ.”
يعاني تناول حنفي ﻟ “التنوير الأوربيّ” و”التنوير الإسلاميّ” من أسلوب “الكيل بمكيالين” الذي يتّجسّد في تغيير المعيار الأساسيّ الذي يتمّ من خلاله تقييم كلّ “تنويرٍ”. فما يأخذه حنفي على فلسفة التنوير، بالدرجة الأولى، لا يكمن في سلبيّة القيّم التي تدعو إليها؛ فهذه الدعوة إيجابيّةٌ – بالنسبة إلى حنفي – لدرجة أنّه عدّها “دعوةً إسلاميّةً خالصةً”، وإنّما يكمن هذا المأخذ، تحديدًا أو خصوصًا، في عجز قيم التنوير برأيه عن أن تكون راسخةً في الوعي الأوروبيّ، ومؤثّرةً في سلوكه. لكنّ حنفي يتجاهل هذا الأساس أو المعيار تمامًا، في حديثه عن “التنوير الإسلاميّ”. فهل حضور قيم التنوير في مجتمعاتنا العربيّة أو الإسلاميّة المعاصرة أقوى من حضور هذه القيم في المجتمعات الأوروبيّة المعاصرة؟ من الواضح أنّ “مجتمع العدل والمساواة”، الذي يعتقد حنفي أنّ الإسلام أو تنويره قد أسّسه في مرحلةٍ تاريخيّةٍ ما، قد تلاشى تمامًا تقريبًا. ألا يعني ذلك أنّه من الأَولى – وفقًا لمنطق حنفي نفسه – الحديث عن “حدود التنوير الإسلامي” بوصفها “السبب في عدم رسوخ قيم هذا التنوير، في الوعي العربيّ أو الإسلاميّ، وعدم تأثيرها في سلوكه؟ ثمّ إنّ حنفي يعتبر “التقدّم” إحدى أهمّ قيم التنوير، و”إحدى الدعائم الأساسيّة في فلسفة التنوير على كلّ المستويات […].” فهل ثمّة مجالٌ أو معنىً للحديث عن تقدّمٍ فكريٍّ (أو عقليٍّ، كما يسميه حنفي)، مع القول، في الوقت نفسه، إنّ قيم التنوير قد أُنجزت، إنجازًا كاملًا، منذ قرونٍ طويلةٍ؟ وإذا كان التقدّم يعني “حركةً إلى الأمام، بالمعنى الوصفيّ أو المعياريّ أو كلاهما، ألا يعني ذلك أنّ قيمة التقدّم في التنوير، “الإسلاميّ وغير الإسلاميّ”، تتناقض مع تلك العودة إلى الوراء، التي يبدو أنّ حنفي يدعونا إلى القيام بها، للتزوّد بالحقيقة الناجزة الكاملة أو المكتملة، في ماضٍ ما؟ وفي مناقشته لمفهومي “الإنسان” و”الأمّة”، انتقد حنفي نزعة بعض الحضارات “للتّمركز حول الذات” بحيث “لا ترى أبعد من ذاتها”، كما انتقد “النظريّات العنصريّة التي تمجّد الأمّة من حيث هي شعبٌ يتميّز بخصالٍ فريدةٍ دون غيره”، كما رفض زعْم أيّ أمّةٍ أنّها »غاية التاريخ وكمال الإنسانيّة ونهاية التطوّر وآخر المطاف.” ألا يقع فكر حنفي في ما يشبه هذه النزعة وهذا الزعم، عندما يقول بعجز الوعي الأوروبي عن امتلاك شعورٍ حضاريٍّ “قادرٍ على الحفاظ على مثل فلسفة التنوير يكتمل الوحي فيه”، وبأنّه ربما نكون نحن – شعوب العالم الثالث أو الشعوب الإسلاميّة – “ممثلي هذه الإنسانيّة الجديدة”؟
وفي نهاية هذا النقاش المكثّف والموجز، مع حنفي، ينبغي التشديد أنّ تنديده بما أسماه “الانحراف نحو الغرب”، لم يفضِ عنده إلى رفضٍ لدراسة “التنوير الغربيّ”؛ لكنّه يرى أنّ مهمّة الباحثين في هذا المجال ينبغي أن تقتصر على “مقارنة فلسفة التنوير بالتراث الاعتزاليّ وبروح الإسلام كما عبّر عنها الوحي من أجل إيجاد أوجه التشابه بين التيارين، ومعرفة أسباب قصور فلسفة التنوير وعدم رسوخها في أعماق الوعي الأوربيّ.« ونحن نعتقد أنّ هذه المهمّة ينبغي أن تتضمّن، أيضًا وخصوصًا، معرفة “أسباب ضعف قيم التنوير وعدم رسوخها في أعماق وعينا وفي مجتمعاتنا العربيّة أو الإسلاميّة”. فعلم الاستغراب، الذي يعكس العلاقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف – بحيث يصبح الغرب موضوعًا لدراستنا بعد أن كان “ذاتًا” تدرسنا وتدرّسنا – لا ينفي ضرورة أن نبقى موضوعًا للدراسة. كما لا نعتقد بضرورة أو فائدة وضع الفكر العربيّ أمام تخيّيرٍ يمارس كلّ طرفٍ فيه دور الإقصاء تجاه الطرف الآخر. فالتنوير “العربيّ” أو الإسلاميّ” المنشود إحياؤه أو بناؤه أو قيامه، لا يقتضي بالضرورة التعارض أو التناقض مع التنوير الغربيّ، ولا ينبغي ردّ أحدهما إلى الآخر واختزاله إليه، كما يفعل حنفي، الذي يعتبر التنوير الغربيّ مجرّد تكرارٍ، غير أصيلٍ وغير مكتملٍ، لتنويرٍ إسلاميٍّ، جاء به الوحيّ، وقام المعتزلة ببنائه وتوضيح أسسه. فلا ينبغي لأيّ فكرٍ أو أمّةٍ أو جهةٍ ادّعاء امتلاك الحقيقة المطلقة والكاملة والناجزة. فمثل هذا الادّعاء قد يعبّر عن مدى جهل المدّعي، أكثر مما يدلّ على امتلاكه لتلك الحقيقة المزعومة. ومن الضروريّ، أو من المفيد، في هذا السياق، استحضار رأي ابن رشد الذي أكّد وجوب النظر في كتب الأمم السالفة أو المعاصرة، “فإن كان كلّه صوابًا قبلناه منهم، وإن كان فيه ما ليس بصوابٍ نبهنا عليه” وينبغي للحكمة أن تكون “ضالّة المؤمن” وغير المؤمن، بغضّ النظر عن مصدرها أو مكمنها.
……………………
هذا النص جزء من بحث نُشر سابقًا، وسيكون ضمن كتابي “العدالة والهوية: نقد المقاربة الثقافوية في الثقافة العربية الإسلامية الذي سينشره مركز دراسات ثقافات المتوسط/ دار المتوسط “قريبًا”.
وأعيد نشر هذا النص بمناسبة النقاشات التي جرت منذ قليل عن هذا الموضوع في المؤتمر الدولي الثاني لمعهد الدراسات والتربية الاسلامية بجامعة مونستر بألمانيا الذي ينظم بالشراكة مع معهد العلوم الإسلامية بجامعة توبينجن الألمانية والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية ومؤسسة APTEES ستراسبورغ ، فرنسا. وقد شاركت في المؤتمر بورقة تحمل العنوان التالي: “في تجديد الخطاب الديني: تحليل للمفاهيم وللضوابط الداخلية والخارجية”.