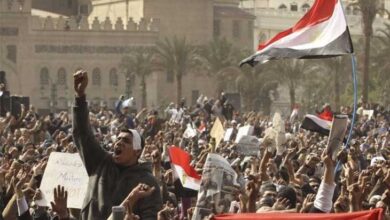ملقّحون وجهلة… أو كيف تتحوّل كل الأسئلة إلى «حرب ثقافية»/ محمد سامي الكيال

صارت الاحتجاجات ضد التلقيح الإجباري من وباء كورونا، وما يرتبط به من مسائل، مثل إجراءات العزل والإغلاق، في قلب الصراع السياسي في الدول الغربية. كما أن ملاحظة الحجج المختلفة، التي يقدمها معارضو التطعيم ومؤيدوه، تبيّن بوضوح الأبعاد الاجتماعية والأيديولوجية للقضية. لسنا هنا أمام صراع علمي بسيط. يقدّم أحد أطرافه حقائق بسيطة وجاهزة، فيما يرفضها الطرف الآخر، لأسباب تتعلق بالجهل والتعنّت فقط.
ليس كل معارضي التلقيح الإجباري من أنصار نظرية المؤامرة.. ولا ينتمون فقط إلى اليمين المتطرف، وليسوا جمعيهم ممن يمارسون «التمييز ضد الضعفاء وكبار السن» كما يقدمهم جانب كبير من الإعلام السائد. فبحث بسيط في ما يقولونه وينشرونه يبيّن أنهم يطرحون منظومة متماسكة منطقياً من الحجج، وإن كان هذا لا يعني أنها صحيحة بالضرورة: اللقاحات فشلت في تحقيق ما كان منتظراً منها، فهي لا تمنع نقل المرض من شخص إلى آخر، ولا تقدّم حماية كبيرة وفعّالة ضد انتشار المتحورات الفيروسية الجديدة. كما أن البلدان التي حققت أعلى نسبة تلقيح لمواطنيها لم تتخلص من الوباء، ولم تنجح حتى بإعاقة انتشاره، فضلاً عن أن اللقاحات لا تقدم إلا حماية مؤقتة تزول بسرعة، ويبدو أنه لا نهاية لدعوات تلقي «جرعات معززة» وبالتالي فمن حق البشر في هذا الظرف أن ينتزعوا الولاية على أجسادهم من الدولة، ويقرروا بأنفسهم إن كانوا يريدون تعاطي اللقاح من عدمه، دون أن يتعرّضوا للتشهير أو الاتهام بخرق «التضامن الاجتماعي». أنصار التلقيح الإجباري يركزون عادة على الحجج الأضعف، والأكثر ارتباطاً بنظرية المؤامرة لدى خصومهم، لكنهم عندما يردون يقدمون بدورهم حجة متماسكة: ثبت أن اللقاحات تقي من تدهور الحالة المرضية للمصابين. وتقلل من ضرورة إسعافهم للمستشفيات، وبالتالي فإن التلقيح الشامل يقلل العبء على النظام الصحي، ويتيح التركيز على الأشخاص الأكثر ضعفاً والأقلّ مناعة، ولذلك يبقى تلقي اللقاح نوعاً من التضامن.
يمكن نقد وتفنيد كلا الحجتين، لكن المهم هنا أن الصراع ليس بين متمسكين بالعلم وجهلة، أو طيبين وأشرار، بل يتعلّق بكل القضايا السياسية والاجتماعية الأساسية في عصرنا: سلطة الدولة وحدودها؛ السياسات الحيوية وحالة الاستثناء؛ الحريات الفردية والتضامن الاجتماعي؛ أين يبدأ وينتهي حق تقرير المصير الفردي؛ الجوانب الطبقية لهيمنة السلطة التنفيذية على حياة البشر؛ علاقة الديمقراطية بالتحكّم البيروقراطي/التكنوقراطي في المجتمعات الأكثر تطوراً.
أهمية هذه القضايا تدفع للتساؤل: لماذا لا تتم مناقشة كل هذه الأسئلة بشكل مفتوح ومباشر، بدلاً من تحويل المسألة إلى فصل جديد من «حرب ثقافية» تتعلّق أساساً بنمط الحياة، بين فئة تحتكر الحق والحقيقة وأخرى متمردة عليهما؟ وكيف أصبحت «الحقائق» سهلة وبسيطة إلى هذه الدرجة، لتسدّ الطريق على أي نقاش سياسي، مهما بلغت أهميته؟
الخلاص بالدولة
عندما حذّر الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين، مع بداية الوباء، من حالة استثناء صحي تزيد من تغوّل السلطات التنفيذية، اعتبر كثيرون أنه ما يزال عالقاً في نظرياته المعروفة، وغير قادر على فهم التطورات المعاصرة الأكثر أهمية. وبالفعل تم التطبيع مع إجراءات لم يكن من المتصور أنها ستتم يوماً في دول ديمقراطية. إلى أن جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول رافضي التلقيح، والتي استغرب كثيرون صدورها عن رئيس دولة، ليس من مهمته أن يوضح للبشر «خطأهم الأخلاقي» ولا يحقّ له إعلان نيته بـ«التضييق» على فئة كبيرة من مواطنيه.
فكرة «الخطأ الأخلاقي» التي عبّر عنها ماكرون قد تشير إلى تطور أساسي في الأيديولوجيا السائدة المعاصرة، فالخلاف السياسي لم يعد ينبع، وفق هذا المنظور، من تضارب في المصالح والمواقع الاجتماعية، أو قناعات مختلفة لدى البشر، لا يمكن اعتبار إحداها الحقيقة المطلقة، وإلا انتفت الحاجة للسياسة والجدل في الحيز العام أصلاً، بل من مشكلة أخلاقية لدى البعض، ممن يجب نبذهم والتضييق عليهم، لأنهم لا يريدون تجاوز جهلهم أو عنصريتهم أو انعدام مسؤوليتهم. وبالتالي فإن من يتمتعون بالصواب الأخلاقي يعبّرون عن حقائق وحقوق مجرّدة، ويمارسون ما هو أعلى من السياسة والأيديولوجيا: نصرة الحق نفسه، لكن من أين يأتي هؤلاء بحقائقهم البسيطة والواضحة كالشمس؟
ربما يجب البحث في ما يمكن تسميته «بنية الحقيقة» في المجتمعات المعاصرة، أي مجموعة المؤسسات المتخصصة في مجالها، التي تصدر عدداً من البيانات العلمية، إلا أن هذه البيانات، من إحصاءات وتجارب ونتائج، لا يمكن أن تنتج لوحدها مركباً معقداً مثل «الحقيقة» خاصة إذا كان المراد تطبيقه في الحقل الاجتماعي والسياسي. لا بد من طرف ما يعطي معنىً متكاملاً ومتسقاً لكل تلك البيانات المتفرّقة، أي يقدمها بوصفها مرافعة سياسية وأيديولوجية. ويبدو أن هذا الطرف في شرطنا المعاصر هو مجموعة من البيروقراطيين والتكنوقراطيين، الذين لا يهتمون بتقديم أنفسهم بوصفهم أصحاب دعاوى سياسية واجتماعية، بل مختصين محايدين أيديولوجياً. من هنا يبدأ الاختلال في نظام السياسة الحالي، إذ تصبح معارضة أي سياسة يسعى هؤلاء لفرضها تمرداً على الحقيقة نفسها، لأن السياسة البيروقراطية/التكنوقراطية ترفض اعتبار نفسها سياسة أصلاً، بل إدارةً للأزمات في أحسن الأحوال.
بهذا المعنى تغدو الدولة، بوصفها تركيباً سياسياً/أيديولوجياً، مصدراً لحقائق مجردة، وتلعب دوراً أبوياً، أشبه بالدور الذي كانت تلعبه الكنيسة في ما مضى. بوصفها مؤسسة تمتلك «أسراراً» مرتبطة بالوحي الإلهي، أي «الحقيقة» كلها. وبالتالي فإن الالتزام بتعليمات هذه المؤسسة يؤسس لنمط حياة صالح. يحق لمن يتبعونه إدانة هرطقات الآخرين، ممن لا يقبلون «العقيدة القويمة».
كتب أغامبين مقالاً في ما بعد قال فيه، إن الطب الحديث غدا دوغما جديدة، وإن مهمة الفلاسفة اليوم أن يوضحوا الأسس الفكرية لهذه الدوغما. وربما كان هذا الطرح يستحق التأمل.
العلم بوصفه عقيدة
إحدى الظواهر اللافتة في عصرنا وصم منتقدي رأي سائد ما، بوصفهم «مشككين». ما يطرح سؤالاً مهماً: متى كان التشكيك وصمة عار على أصحابه؟ ألم يقم العلم دوماً على التشكيك بالمعارف السائدة، وإعادة التحقق منها على أساس منهج معين، يمكن تعميمه وشرحه في الحيز العام؟ ألم يكن كوبرنيكوس نفسه مشككاً بعلم الفلك البطلمي، وآينشتاين مشككاً بالفيزياء النيوتنية؟ لا يعني هذا بالتأكيد أنه يمكن لأي جاهل أن يتطاول على الأسس المنهجية المعقدة التي يقوم عليها عمل المؤسسة العلمية، لكن اعتبار «التشكيك» بحد ذاته مشكلة قد يشير إلى أن العلم المعاصر قد فقد دوره النقدي والتحرري. وصار منتجاً لعقائد جامدة، يمكن للسياسيين فرضها، دون أن يلوثهم ذلك بشبهة الأيديولوجيا، أي ادعاء أن كل ما يقومون به مجرد اتباع مخلص لما تفترضه «الحقيقة».
إلا أن السياسات المعاصرة مع وباء كورونا لا تبدو بريئة من الأيديولوجيا لهذه الدرجة: انتهكت الدول الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، باسم ضرورات مواجهة الوباء، ولم تنجح بالقضاء عليه، أو الحد من انتشاره، أو حتى تطوير خدماتها الاجتماعية الأساسية. مطالبةً، في الوقت نفسه، البشر بالخضوع لما تقرره بخصوص أجسادهم، وشؤون حياتهم وموتهم، ونشاطهم الاجتماعي في مجالاته المختلفة، ألا يحق للمواطنين، بوصفهم أطرافاً في عقد اجتماعي مفترض، رفض هذه السياسات؟ واعتبار أن الإجراءات التي تفرضها الدول غير ناجعة، ولا تفيد إلا بتعظيم صلاحيات السلطات التنفيذية، والمداراة على تهالك القطاع الصحي، نتيجة سنوات طويلة من السياسات النيوليبرالية؟ أليس استخدام «العلم» لإدانة كل اعتراض، يجعله مجرد عقيدة سلطوية، يجب نقدها منهجياً؟
السياسة بدل «الحقيقة»
بالعودة إلى مسألة اللقاحات فإن «المشككين» يطرحون رأياً يستحق الاحترام والمناقشة: ما دامت اللقاحات غير قادرة على منع العدوى، ونقلها إلى الفئات الأضعف، فيجب أن يبقى قرار تعاطي عقارات، لم تجرّب بالشكل الكافي، مسألة شخصية، يقررها كل إنسان، نظراً لحقه في الولاية على جسده، كما أن الدولة يجب أن لا تحظى بسلطات جديدة غير محدودة، باسم مواجهة حالة الاستثناء الصحية. أما الضغط على القطاع الصحي فيجب مواجهته بتطوير هذا القطاع، أي توسيعه ليتناسب مع حاجات المجتمع، لا بسلب حقوق المجتمع لتتوافق مع محدودية قطاع صحي أنهكته سياسات نيوليبرالية، توفّر مئات المليارات لإنقاذ الشركات الكبرى في الأزمات الاقتصادية، ولا تهتم كثيراً بزيادة الاعتمادات المالية، لتأهيل كادر طبي جديد، وبنية تحتية صحية مناسبة لمجتمعات معرّضة لأوبئة عالمية.
نزع سياسية هذا الطرح، وجعله مجرد ظاهرة من ظواهر «الجهل» جانب من تحويل كل جدل سياسي إلى حرب ثقافية، وأقرب لنزاع بين هويات متعارضة، يطوّع فيها «الصالحون» نمط حياتهم، بما يتناسب مع الحقيقة/الدولة، ما يؤهلهم لإدانة «المهرطقين» وربما لهذا قد يكون للهرطقة دور تنويري وتحرري كبير في زمننا.
كاتب سوري
القدس العربي