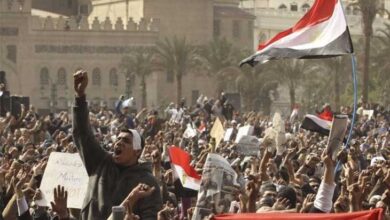أوبرا وينفري: سيمياء الصورة وفرجة الاستهلاك/ علي حسن الفواز

كلُّ شيءٍ في العالم صناعة، وترويج وتسويق، وبالاتجاه الذي يجعل هذه الثلاثية تملك مؤسسات وطواقم تشبه أندية كرة القدم، حيث الاحتراف والسوق والنجوم، وحيث الحرفنة التي تقوم على الأداء الفائق، لكن ما يميزها هو امتلاكها لكثيرٍ من الطاقات الفيللوجية، ومن السرديات التي تحكم خطاب السوق والإشهار، تتحول فيه الموجودات إلى أدوات للفرجة، والمتعة والاستهلاك، بما فيها البشر مهما كانوا، بوصفهم كائنات لغوية، وسلعا قابلة للتداول، فالعالم أزاح القداسة عن الإنسان، إذ طرده من التاريخ وتركه للسرد، لتتشكل صورته، حسب مواصفات حاجة السوق والوظيفة والسلطة والأيديولوجيا، وربما وفق حاجة الخطاب في سياقه التداولي..
أوبرا وينفري تملك حظوة وشطارة المرأة الاستعراضية، فهي تجيد التمثيل والتسويق، مثلما تجيد لعبة تقويض الخطاب العنصري الأمريكي، لاسيما وهي تعمل في «سي بي أس» وهي أخطر المحطات التلفزيونية شهرة وثراء وتسويقا، فضلا عن كونها صديقة الرؤساء والرئيسات في الحكم وفي القصر، وهذه وظيفة استثنائية تضاهي إلى حد كبير وظائف الرأسماليين، الذين يملكون ثلاثة أرباع العالم، لكن ميزة وينفري أنها تملك القدرة على تحريك مزاج الكبار، وطبعا حركة هذا المزاج تشبه حركة أسطول بحري.
المرجعيات السينمائية لوينفري» جعلتها أكثر مهارة في إنتاج مرجعيات واقعية في سياق برامجها التلفزيونية، لاسيما وأنها جزء من مدرسة سينما المفارقة التي أسسها المخرج ستيفن سبيلبرغ، فبقدر حيوية اختيارها للشخصيات، فإنها تعمل بطريقتها الناعمة والهادئة والساخرة، على تحويل الجو التلفزيوني إلى منصة للاعتراف والكشف، بما فيها الاعتراف بفضائح شخصية، وهذا ما أكسبها شهرة سريعة، وتفاعل مع جمهور عريض يتلذذ بالفضائح الخاصة..
وينفري وسلطة التلفزيون
لا تشتغل وينفري على تسويق المعلومات، فهناك مصادر كثيرة للحصول عليها، كما لا تعمل في السياسة، وهي مهنة الملل والكآبة والخداع، بل تجد في لعبة الاستعراض مجالها الأرحب، حيث تتخلى الشخصيات المُستضافة عن هيبتها الرئاسية، أو الطبقية أو الكارزمية، لتبدو في الشاشة وكأنها بعض شخصيات «والت ديزني» تدعو للحميمية، وتثير الضحك والتعاطف، وهي حساسيات يتناغم معها الجمهور الأمريكي بشكل خاص، ليس لأنه يكره الأقنعة التي يلبسها أولئك، بل لأنها تكشف غرورهم وأكاذيبهم عبر ما يشبه لعبة «الامبراطور العاري» كما في حكايات الدنماركي هانس كريستيان أندرسن.
لقاءات وينفري مع الرئيس الأسبق أوباما وزوجته، ومع الرئيس كلينتون والسيدة هيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة، وكذلك مع الرئيس الحالي جو بايدن وغيرهم، وضعت المنصة التلفزيونية وكأنها «مذبح كنسي» للاعتراف، ولنزع الأقنعة والوجاهات، وللقبول بمبدأ «المساواة» مع الآخرين في التفاصيل الحياتية والاجتماعية والجنسية، ورغم ما في الأمر من قصدية قد تقف وراءها مؤسسات تسويقية وإعلامية وإعلانية ومخابراتية، فإنّ الأمر يبدو جاذبا للمشاهد، الذي يريد أن يرى رئيسا يشبهه في الضحك والكلام والاعتراف، مثلما يريد بورجوازيا يتحدث عن الإفلاس والغنى والفشل والطموح، وعن حياته السرية مع المال والنساء والسياسة. ولعل لقاءها الأخير مع المتمرد الإنكليزي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، يكشف عن حيوية المنصة التلفزيوية، وعن اللعبة المؤنسنة للحوار، فضلا عن ما يفضحه لفضول الجمهور من أسرار ذلك التمرد على العائلة الملكية، والبحث عن ملاذ أمريكي، وكأنه يقول أنا أعشق نموذج الحرية الأمريكية، بقطع النظر عن ذاكرة العنصرية، وعن الحكايات التي بدأت تطال حياته، وعن أسرار لون بشرة طفله القادم، وهذا الاعتراف سيقلل من صدمة عنصرية اللون، ومن الخروج عن التقاليد البروتستانتية والملكية، بوصف أن الملكة اليزابيث هي صاحبة السلطتين الدينية والدنيوية في بريطانيا وفي عالم الكومنويلث.
خطاب الفرجة وسيمياء الصورة
الوصلة الإشهارية كما يسميها سعيد بنكراد لبرنامج وينفري، تحمله سلسلة من المضامين، والرسائل التي لا تُعنى بالخدمات الثقافية، بل بسيمياء الشخصيات، حيث تتحول هذه الشخصيات إلى بؤر جاذبة، وإلى وظائف تؤدي فعاليات المتعة والخوف والكراهية والعصيان والتمرد، بما فيها التمرد على النسق، كما حدث مع الأمير هاري، أو في التعبير عن الشغف كما حدث مع الرئيس بايدن.
المستهلك التلفزيوني ليس عامل المطعم، ولا الحداد في مشغل الحديد، ولا بائع الخردوات، بل إنها تصنع سيمياء الصورة وخطاب الفرجة لجمهور طبقي يتابع «الغايات الإشهارية» بما تحمله من معنى أو من ربح، أو قيمة لها بعدها الأيديولوجي، وحتى العنصري، وليجد هذا المستهلك «توتره الدلالي» في اللغة التي تصنع سياقها وينفري، وفي طريقة تقديمها وتأثيرها عبر التمثيل، فهي تقدّم رسالة أمريكية للعالم تصنعها امرأة سوداء، لضيوفها الكبار- أغلبهم من البيض- لتصنع مشهدا تذوب فيها نقائض اللون والتاريخ، ليحضر في المقابل الخطاب الذي يشبه الجسد في إغوائه، وفي عفويته المقصودة، حيث «يتحول ضمنها الاستعمال الوظيفي إلى فرجة تتداخل فيها كل الدلالات البعيدة منها والقريبة» كما قال بنكراد.
هل يمكن لوينفري أن تستضيف رئيسا عربيا مع زوجته؟ أظن أن الجواب سيكون بالنفي، ليس لأن البرنامج أمريكي خالص، وأن مشاهدته مدفوعة الثمن، وأن ضيوفه ينبغي أن يكونوا نجوما، وطبعا هذه الصفة غير متوفرة في الرؤساء العرب، رغم الضجيج الاعلامي عنهم وحولهم، وهذا ما يسقط اعتبارهم جزءا من خطاب الفرجة وسيمياء الصورة.
وينفري وصناعة صدمة التلقي
الصدمة تستنفر مخيلة المستهلك، وتضعه في سياق إغوائي لتقبل المتعة، بما فيها متعة الكراهية، فلقاؤها الأخير مع رجل العائلة المالكة النافر عن السلالة، والكاره للدم الأزرق، بدا وكأنه يصنع عبر البرنامج عالما سرديا كامل المواصفات، فيه رغبة التمرد، والخوف على أن يكون مصير زوجته وأطفاله مثل مصير أمه الأميرة ديانا، وهذا ما جعل ساعات بث اللقاء أشبه بمشاهدة فيلم رومانسي كثير الإثارة، فالشغف الطبقي، يتشهى حديث التمرد على السستم الملكي، والشغف الاجتماعي يبحث عن الاسرار، وعن ماذا يدور في خفايا العائلة التي تحكمها امرأة هائلة القوة والأناقة والحرص الطبقي والملكي.
لا أحسب أن وينفري قدمت برنامج محايدا، بل إنها اصطنعت صدمة التلقي لتصنع منظورا للصورة من جانب، أو لجذب تلك الشخصية الفائقة لتقدّم تحولها من شخصية ملكية إلى شخصية عمومية، يمكن الحوار معها، وإخضاعها إلى أي تحليل سردي، فالأمير رغم صغر سنه، قد يفكر بكتابة مذكراته لكي يجعل من سيمياء صورته، مجالا للربح، فما بعد المرحلة الملكية ستبدأ المرحلة التجارية.. لقد ادركت المرأة سر اللعبة، هذا ما قاله جان سيغيلا، فعبر تقانة وشطارة في التمثيل والترف الإعلامي تمكنت من أن تضع الكثيرين في سياق التلقي، وفي القبول بالإشهار، الذي يخص الشخصية وخطابها، مثلما يخص المضمون مهما كان تافها، فهي لا تستضيف فلاسفة ولا أصحاب نظريات في الفيزياء والكيمياء والأنثروبولوجيا، بقدر ما أنها تسعى وبخبرة متراكمة إلى صناعة فضاء إعلاني هائل، إعلان يخص الشخصية، ويخص الزمن المستقطع من البرنامج، لتقديم إعلانات عن الصابون والشامبو، أو عن ماكنات الحلاقة أو الترويج لدواء عن العجز الجنسي..
المهم في الأمر أن تكون صناعة التلقي خاضعة لقصدية إعلانية، وليست قصدية فينومينولوجية، حيث الأشياء مكشوفة، والمضمون لا يحتاج إلى تأويل وإلى جدل، وحيث تبدو الفكرة، مهما كانت ساذجة، صالحة لتذكير الجميع بأن العالم – وسط جائحة كورونا، ووسط الحروب والبشاعة – يحتاج إلى شيء من العافية والنعومة واللذة، بما فيها نعومة اللغة التي تصلح لمواجهة خشونة السياسة، التي مازالت بعض فخاخها مفتوحة للعابرين من طيبيّ النوايا.
كاتب عراقي
القدس العربي