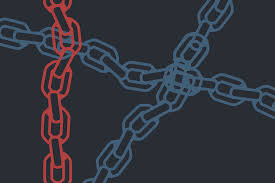ملف صادق جلال العظم (1934-2016)… ومحاكمة فكر القبيلة

تبرز باستمرار أهمية استعادة أعمال وكتابات الفيلسوف والمفكر السوري صادق جلال العظم. فبالإضافة إلى نتاجه الفكري والثقافي، مازالت سيرته الذاتية الشخصية ومسيرته الأكاديمية النشطة والجدلية تتطلبان البحث فيهما بشكل أوسع. وهذا ما يسعى إلى تحقيقه ملف رصيف 22 عن هذه الشخصية الاستثنائية.
فتتنوع المواد التي يقدمها الملف، فمنها ما يتعلق بحياة العظم الشخصية الذاتية والعائلية والعاطفية وشهادات من الأصدقاء، ومنها ما يتعلق بمسيرته المهنية والأكاديمية ومن بينها مادة بحثية هامة من أرشيف الجامعة الأمريكية، وكذلك تتعلق المواد الأخرى بكتاباته الفلسفية ونصوصه في النقد الفني والأدبي والمسرحي، وأخيراً يضم الملف قصة مصورة تروي حكاية شاب من دمشق، غيرت كتب العظم حياته.
من الحب إلى العائلة ومن الصداقة إلى الزمالة
يتضمن الملف لقاء أجرته سامية التل مع د.نبيل دجاني الأكاديمي في مجال الاتصال الجماهيري، والذي جمعته بالعظم علاقة صداقة طويلة دامت حوالي الستين عامًا، فعرفه تلميذًا وأستاذًا في الجامعة الأميركية في بيروت، والتقى مشوارهما في محطات عديدة.
يخبرنا دجاني عن الجانب العاطفي في حياة العظم من الحب والزواج الأول رغم معارضة الأهل. كما يروي لنا حكاية تخفي العظم خوفاً على حياته من تهديد الإسلاميين، ومن الأخطار التي كانت تحدق بالعظم، بسبب المواقف المتحدية والشجاعة والجريئة التي تضمنتها كتبه وأنشطته الثقافية. كما يذكر دجاني الاعتذار الذي قدم من قبل الجامعة الأمريكية في العام 2017 للعظم، والذي اعتبره قد جاء متأخراً.
الأكاديمي الإشكالي بين المدن العربية
في نص” جانب من مسيرة مفكر إشكالي” يعلمنا الكاتب محمد شيخ أحمد عن أثر قراءته لكتاب “نقد الفكر الديني”، الذي حسم موقفه لدراسة الفلسفة. ويقدم الكاتب رؤيته للمسيرة الفكرية للعظم: “كان مفكراً إشكالياً من الطراز الرفيع، وصاحب عقلية نقدية وعلمية جدالية، همّها تفكيك التابوات والولوج للأعماق المظلمة في الفكر والمجتمع الإنسانيين، لاستجلاء مكوناتهما ورفع الحصانة عنهما.
وتحت عنوان “بين دمشق وبيروت” يتطرق النص إلى علاقة العظم مع هاتين المدينتين: “لكل من المدينتين بصمتها الخاصة التي لا تمحى في حياة ومسيرة وفكر صادق جلال العظم، وإن اعتبر نفسه دمشقياً شامياً بامتياز، إلا أن الفترة الزمنية التي عاش فيها في بيروت أكبر من تلك التي عاشها في دمشق”، ومن ثم انتقاله للعمل ضمن أطر المقاومة الفلسطينية، حيث ساهم في مركز الأبحاث التابع لها في بيروت مع مجموعة من المثقفين، حاولوا فيها كسر جدار الوهم والغموض تجاه إسرائيل.
أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت
يضم الملف أيضاً نصاً هاماً بعنوان: “ماذا يكشف لنا أرشيف الجامعة الأميركية عن ردات الفعل على عدم تجديد عقد صادق العظم؟”، وهو بحث في الوثائق الأرشيفية للجامعة الأمريكية عن الجدالات الإدارية المتعلقة بعدم تجديد عقد عمل صادق العظم كمدرس في الجامعة الأمريكية، وعن بيانات لجنة الدفاع عن الحريات الجامعية، وعن التحركات الطلابية، وعن بيان منظمة الطلاب العرب التي وقفت بمجملها للدفاع عن العظم وكشف الأسباب الحقيقة وراء منعه من التدريس، وعدم تجديد عقده.
الحب الآني الشديد مقابل الحب المستقر في الديمومة
في الإطار الإنتاج الفكري والفلسفي، يطلعنا الكاتب عمار المأمون في نص بعنوان “الحب ضد الدنكيخوتية” على المقاربات الفلسفية والعلم- نفسية لمفهوم الحب في كتاب “الحب والحب العذري، 1968”. ويصف الكاتب أسلوب العظم في هذا الكتاب بالعقلاني، النافي بحزم والمتقبل بحسم، المتهكم في بعض الأحيان، خصوصاً أنه يناقش موضوعاً عصياً على التعريف الدقيق، أي الحب.
إبليس البطل التراجيدي المخلص للخالق
وفي إطار النصوص الفلسفية أيضاً، يفتتح الكاتب محمد دريوس نصه “مأساة إبليس، مأساة العاشق ورجل الظلّ” بتقديم تاريخ موجز عن شخصية إبليس الذي يصنفها ضمن إطار ابتكار المخيال الإنساني الأدبي الديني. ويتنقل النص إلى الرؤية الخاصة بمأساة إبليس عند صادق العظم، التي تجعله: “بطلاً تراجيدياً مخلصاً لخالقه لكنه مكروه من عباد خالقه، فهو وقع في تناقض فرضه التعارض بين الأمر الإلهي والمشيئة الإلهية”.
يسمي الدكتور العظم التناقض الذي وجد إبليس نفسه فيه بالـ “غربة”: “الشيطان عبد مخلص، بل هو أكثر إخلاصاً من باقي الملائكة والرسل، وقام بتضحية عظيمة خضوعاً لمشيئة الرب وهو يعلم أن عاقبتها وخيمة وأبدية، ولهذا يطلق عليها لقب تراجيدي خاص بمأساة فريدة لعاشق فريد”.
النظرية النقدية الأدبية والجمالية
يتناول نص “العظم ومزايا الأدب” للكاتب علاء رشيدي النظرية النقدية الأدبية والفنية التي خطها العظم في كتابه “ذهنية التحريم” في الفصل الذي يحمل عنوان: سلمان رشدي وحقيقة الأدب. يدافع فيه صادق العظم بشدة عن التقنيات الفنية والتخيلية في الرواية، ويؤكد على ضرورة التمييز بين الروائي الأديب وبين المؤرخ.
كما يطلعنا النص على اهتمام صادق العظم بأدب شرقي يسعى إلى تحرير الشرق من جهله وأساطيره وخرافاته وديكتاتوريته العسكرية وحروبه الطائفية والمذهبية وهامشيته الكاملة في الحياة المعاصرة.
يرفض صادق العظم أي وصاية فكرية على الأعمال الفنية أو البحثية التي تعارض المقدس، واتهم النقاد العرب بتطبيق دور الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بدلاً من الدفاع عن حرية التعبير وحق الكاتب في المساءلة والشك، مذكراً بالرقابة التي مارستها الثقافة العربية. وأخيراً، يستخلص لنا النص رؤية العظم عن دور النقد الأدبي.
كما يتقدم الملف مادةً من نوع القصة المصورة، تجسد حكاية شاب من دمشق مع كتب صادق جلال العظم التي حملها من دمشق إلى بيروت في الثمانينيات، وكيف تأثرت رؤيته للعالم السياسي والديني من حوله بعد قراءته لها. لقد استلهمت الفنانة هذه الحكاية-التجربة، الذاتية-الفكرية،لتحقق منها عملاً فنياً من نوع القصة المصورة.
يشكر فريق رصيف22 مؤسسة صادق جلال العظم وأسرته على منح الموقع صورًا حصرية من أرشيف العائلة
——————————-
نبيل دجاني ومحطّات مع صادق جلال العظم
سامية التل /فريق تحرير قسم ثقافة
جمعت الدكتور نبيل دجاني بصادق العظم علاقة صداقة طويلة دامت حوالي الستين عامًا، فعرفه تلميذًا وأستاذًا في الجامعة الأميركية في بيروت، والتقى مشوارهما في محطات عديدة.
الدكتور نبيل دجاني الحاصل على شهادة الدكتوراه في الاتصال الجماهيري من جامعة أيوا في الولايات الأمريكية المتحدة، شغل العديد من المناصب الرفيعة في المجالين الأكاديمي والإعلامي. فقد كان أستاذ الدراسات الإعلامية في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية في الجامعة الأميركية في بيروت، وشغل أيضًا منصب مساعد عميد كلية الآداب والعلوم، وكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ.
استرجعنا في المقابلة التالية مع الدكتور دجاني أهمّ ذكرياته مع صادق جلال العظم، فأخبرنا عن: بدايات الصداقة والنشاط الحزبي وقصص الحب وحتمية الفراق.
تعرّفت على صادق جلال العظم عام 1953 حين دخلتما إلى الجامعة معاً. ماذا تذكر عن اللقاء الأوّل؟ وكيف دامت صداقتكما حوالي الستين عاماً؟
تعرّفت على صادق في الاجتماعات الدوريّة التي كان يعقدها الحزب السوري القومي الاجتماعي. ففي تلك الفترة، كنّا عضوين نشطين في الحزب. وبالإضافة إلى العلاقة الحزبية، جمعني بصادق انسجام وتقارب فكريّ كبير، وهو ما أظنّه كان سببًا أساسيًّا في عمق الصداقة ودوامها كلّ هذه المدّة.
“وكنّا تنيناتنا نسونجيّة كمان!” (يضيف د.دجاني ضاحكًا)
ماذا تخبرنا عن تجربتكما الحزبيّة؟
كنّا مقتنعيْن جدًا بمبادئ الحزب وكنّا نشيطيْن في العمل الحزبي، وكانت أغلب لقاءاتنا تتم في “بيت الطلبة” وهو بيت، استأجره الحزب السوري القومي الاجتماعي، في شارع عبد العزيز للطلاب القوميّين في الجامعة الأميركية.
بدأت صداقتنا، أنا وصادق، بنقاشات في فكر أنطون سعادة وفي الفكر السوري القومي. وبعد فترة، ازاداد إيماننا بمبادئ الحزب لكننا في الوقت نفسه صُدمنا بممارسات بعض المسؤولين الحزبيّين.
كنّا مقتنعين جدًّا بمبادئ الحزب ولكن لم نكن مقتنعين بمسؤوليه. وهو ما جعلنا نفترق عنه في فترة لاحقة.
عرفت صادق تلميذاً وأستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت. ماذا تخبرنا عن تجربته في هذه المؤسسة؟
كان صادق يحبّ الجامعة الأميركية ولكنّه في الوقت نفسه كان يرى أخطاء مسؤوليها. وبرأيي، فكره الحرّ هو الذي وضعه في صدام مباشر مع شارل مالك ومع كبار مسؤولي الجامعة، وهو ما كان، في الحقيقة، وراء عدم تجديد عقده. فمثلما رفض صادق هيمنة مسؤولي الحزب السوري القومي الاجتماعي رفض أيضًا هيمنة مسؤولي الجامعة الأميركية.
وفي هذا الصدد، استذكر طرد صادق لأحد عمداء الجامعة الأميركية من منزله بعدما زاره ليطلب منه عدم إحالة طالبة عنده إلى مجلس الجامعة التأديبي بعد أن اكتشف صادق قيامها بـ”سرقة أدبية” أو plagiarism في الأطروحة التي كانت تعمل عليها بإشرافه. وهو ما كان أحد أسباب عدم تجديد عقده في الجامعة.
أحبّ صادق “فوز طوقان” ولم يستسلم لرفض والدها لعلاقته بابنته. ما الذي لفت صادق بفوز؟ وكيف تصف العلاقة التي جمعتهما؟
إنّ ما لفت صادق بفوز، في رأيي، هي شخصيّتها القوية. فصادق كما أعرفه، يجذبه الأشخاص الأقوياء. كما أنّ عقل فوز وسعة فكرها كانت بالتأكيد من العوامل التي زادته حبًا وإعجابًا بها. وبالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنّ رفض والد فوز لعلاقتها بصادق هو ما زاده إصرارًا وتمسّكًا بالعلاقة.
لا أنسى يوم كنّا نتمشّى في شارع الحمرا، وفجأة توقّف صادق وأشار إلى بيت مقابل لنا وقال: “هذا بيت فوز. اشتقت إليها! أريد أن أراها.” وفجأة دخل المبنى وقرّر الصعود لرؤية فوز. لم أستطع أن أمنعه وخفت عليه لأنّي كنت أعرف أنّ والدها كان من بيئة محافظة جدًا، فخشيت أن يصطدم معه.
وبعد وقت قصير، خرج صادق من المبنى وأخبرني أنّه طلب يد فوز من والدها. وعرفت من فوز لاحقًا أنّ والدها أعجب جدًا بشجاعته وجرأته.
من خلال معرفتك الشخصيّة بصادق وقربك منه، ما سرّ شجاعته الكبيرة في عرض أفكاره؟
أعتقد أن شجاعة صادق الكبيرة تعود إلى تربيته المنزليّة. فقد نشأ في بيئة منزلية تميّزت بسقف عالِ من
الحريّات. وكان لهذا الجوّ العائليّ دورًا أساسيًّا، برأيي، في نموه الفكري وفي جرأته الكبيرة في عرض أفكاره.
ذكرت في كلمة وداع صادق أنّه زارك ذات يوم مرتدياً قبّعة غريبة، وعرفت منه لاحقاً أنه كان يتنكّر لأن مجموعة سياسيّة كانت تحاول استهدافه. من كانت تلك المجموعة؟ ولماذا استفزّتها أفكاره؟
المثير للعجب في شأن هذه القبعة أنّها كانت، برأيي، تلفت النظر إلى مرتديها أكثر مما تحجبه، ومع ذلك كان يصرّ صادق على ارتدائها للتخفّي.
كانت مشكلته وقتها، بشكل أساسي، مع الإسلاميين الذين كانوا يعتبرونه ملحداً يحارب الدين. وهو ما كان أيضًا أساس مشكلته مع شارل ملك، ومع المرجعيات الدينية خصوصًا بعد إصداره كتاب “نقد الفكر الديني”.
هل كنت تنصح صادق بالتروّي وتوخّي الحيطة والحذر؟ هل كنت تخاف عليه من تداعيات ثورته على الموروثات الثقافية والدينية؟ وهل كان يسمع النصيحة؟
كنت دايمًا أنصحه بالتروّي وكنت أخاف عليه كثيرًا من جرأته، لكنّه كان مقدامًا لا يردعه شيء. كنت ألجأ إلى فوز، عندما كنت أريد تحذيره من شيء، لأنّها كانت تؤثّر عليه أكثر مني. لكن مع مرور الوقت، وربما بتأثيرٍ من فوز، تعلّم صادق أن يكون أكثر ديبلوماسيّة، بعد أن كانت الديبلوماسية بعيدة كلّ البعد عن صادق.
وازداد خوفي عليه في الفترة التي كان يعلّم فيها في جامعة دمشق. فسألته ذات يوم كيف تمكّن من تفادي الصدام مع النظام السوري. فروى لي، ضاحكًا، قصّة مع أحد طلابه.
أخبرني أنّه بعد أن توفيّ باسل الأسد في حادث سيارة، زاره في مكتبه طالب كان ينوي كتابة أطروحة ماجستير عن الفقيد، وطلب منه أن يكون مشرفًا على أطروحته. كان صادق يعرف أنّه لا يستطيع الرفض؛ فردّ على الطالب بحزم، قائلًا: باسل الأسد يا عزيزي أهم من رسالة ماجستير، فقط رسالة دكتوراه ممكن أن تفيه حقّه!
أحدث كتاب صادق جلال العظم “نقد الفكر الديني” ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية والدينية، وأثار عاصفة من ردود الفعل. وحُكم عليه بالسجن بسبب الأفكار التي عرضها في هذا الكتاب. كيف تعاطى صادق جلال العظم خلال هذه الفترة مع ردّات الفعل حول هذا الكتاب؟
أعتقد أنّ ردات الفعل الصاخبة على الكتاب، كان لها مفعولًا عكسيًّا فبدل أن تردع صادق وتخيفه، زادته قوة وتصميماً، وخدَمَتْه في مكان ما.
هل تعتبر أن الجامعة الأميركية في بيروت خذلت صادق في محنته عام 1970؟ وهل تعتبر أن اعتذار الجامعة على لسان رئيسها في اليوم التكريمي الذي أقامه لصادق عام 2017 جاء متأخراً جداً؟
الاعتذار جاء متأخرًّا طبعًا والجامعة لم تكن بوارد الاعتذار. إذْ كانت تَشْغَلها، برأيي، أمور أخرى في تلك الفترة.
كنتُ أنا أحد من ساهم في اقناع رئيس الجامعة فضلو خوري بإقامة إحتفال لصادق العظم؛ وكان لي دور في اعتذار الجامعة منه. وهو اعتذار، وإن جاء متأخرًا، يستحقه صادق بالتأكيد.
هل تعتبر كتاب “نقد الفكر الديني” أهمّ كتاب تركه صادق جلال العظم؟
نعم لأنه أول كتاب له. ولكن مواقف صادق التي صدرت في كتاباته اللاحقة لا تقل جرأة ولا أهميّة، وأبرزها، على سبيل المثال، دفاعه عن سلمان رشدي.
ما رأيك بموقفه المؤيّد للثورة السورية؟
اختلفتُ معه في موضوع تأييده للثورة. ونبّهته من احتمال تأثّره، ولو بشكل غير مباشر، بالمنظور الغربي للأمور بعد أن عاش سنين طويلة في أميركا وألمانيا. وأذكر أيضًا أني ناقشته بموقفه من “الاستشراق ونظرية المؤامرة” في بريد إلكترونيّ فنّدت فيه النقاط التي اختلفت فيها معه.
كنا نختلف في أمور عديدة ولكن خلافاتنا لم تؤد في أيّ مرة إلى تباعد أو قطيعة.
أمضى صادق جلال العظم أيامه الأخيرة في برلين؟ كيف تصف علاقته بهذه المدينة؟
أظن أنّ الحياة في أميركا وألمانيا منحت صادق مساحة أكبر من حرية التعبير وساهمت في الإضاءة على مواقفه . فاستطاع أن يعبّر عن نفسه وعن أفكاره بشكل أصرح وأوضح. وهو ما افتقده في العالم العربيّ.
وفي الفترة التي عاش فيها صادق في برلين، للأسف، تراجعت صحته بشكل كبير قبل أن توافيه المنية هناك.
نبيل دجاني: “اعتذار الجامعة الأميركية من صادق جلال العظم جاء متأخرًّا!”
لماذا برأيك أوصى أن تُقرأ في عزائه قصيدة “لاعب النرد” للشاعر محمود درويش؟ ولماذا لم يطلب أن يُدفن في سوريا؟
لا أعرف لماذا اختار صادق قصيدة “لاعب النرد” بالذات، لكنّي أعرف أنّه كان شديد الإعجاب بمحمود درويش وشديد التعلّق بالقضية الفلسطينية.
وبالنسبة لعدم رغبته بأن يُدفن في سوريا، أعتقد أنّ موقفه من النظام السوري ومن الوضع السوري بشكل عام كان وراء ذلك.
وختمنا حديثنا مع الدكتور نبيل دجاني بسؤاله عمّا يشغله في هذه الأيام، فأخبرنا أنّه يعمل على كتابة سيرته الذاتية التي اختار لها عنوان “قبل أن أنسى” Before I Forget والتي سيركّز فيها على المرحلة التي كان فيها رئيس جمعية خريجي الجامعة الأميركية ورئيسا لهيئة أساتذة والمرحلة التي كان فيها عضوًا ناشطًا في مجلس شيوخ الجامعة.
—————————-
صادق جلال العظم… جانب من مسيرة مفكر إشكالي/ محمد شيخ أحمد
ما بين القاع الاجتماعي المهمّش في التاريخ السوري، بكل أبعاده المادية والفكرية، والأرستقراطية المدينية العريقة التي انبثق منها صادق جلال العظم، ثمة رابط وحّد بين عالمين، رابط اتسم بالتمرّد على كل ما هو موروث من إرث بطريركي تسلطي وقروسطي، يغلّف الفضاء المجتمعي بصور شتى، تبدأ من لحظة الولادة، وتنسلّ من خلال العرف التقليدي في التربية التي تكرّس الخنوع، الضحالة، الإيمان الأعمى المخدر للعقل، والتسليم لأولي الأمر والنهي المتجسدين بقمة الهرم المجتمعي في السياسة والدين.
وكما تكرّس في لاوعي العظم ما يرمز إليه بيت العائلة العريق في الجسر الأبيض، من خلال ما عناه لوالدته من قمع وقهر وقيد، كذلك عاش في مناخ مدرسة “كمال أتاتورك” السياسية التي كان أبوه وعمه من أنصارها الفاعلين، حيث ساد جو من التسامح والانفتاح والليبرالية، وذلك لأن التديّن في الوسط الأرستقراطي، وحسب العظم، ينحو لأن يكون عملياً، لما تتطلبه موازين السلطة والقوة والعلاقة بينهما.
وعليه، لا بد أن يتسم بالمرونة للمحافظة على المصالح المتبادلة، وإن وجد تعصب فهو لتوكيد البطريركية المسيطرة، كما للجسر الرابط مع العامة عن طريق رجال الدين، لترسيخ السيادة والتسلّط ليس إلا، وهو على النقيض من التديّن الشعبي الذي يجد فيه ملاذه الأخير. وهذا ما غاب عن الدكتور صادق جلال العظم عند حديثه عن “العلوية السياسية” في سياق حديثه عن “الثورة السورية”، وهو ما يحتاج لبحث آخر مجاله ليس هنا.
النافذة التي أشرعها صادق
يمثل العظم الجيل الثالث من روّاد التنوير العربي، إلى جانب لويس عوض، الجابري، جمال حمدان، محمد أركون، مهدي عامل وحسين مروة… إلخ، هذا الجيل الذي أُثقل كاهله بأزمة وجودية بكل أبعادها الحضارية، عقب هزيمة حزيران 1967.
تعرفت عليه بداية عن طريق كتابه “نقد الفكر الديني”، الذي حسم موقفي في دراسة الفلسفة لاحقاً، ليس لأني وجدت فيه ملاذاً لهواجسي، أو مسوغاً لتمردي المبكر على المؤسسات كافة، بدءاً من الأسرية والتربوية والمجتمع والفقر، وحتى السلطة السياسية، وإن كان بشكل عفوي، وإنما لأني وجدت فيه، حينذاك، ذاتي، ما كنت أهجس به خلال صدامي اليومي مع البنى المؤسسة لتركيبة المجتمع السوري، والبيئة المجتمعية التي ولدت فيها.
عرفني على الدكتور صادق جلال العظم فيما بعد رفيق في “حزب العمل الشيوعي” في سهرة في المخيم. كان كواحد منّا، ليس ذاك الأكاديمي صاحب الطريقة والمنهج، ومن حوله مريدون وطلاب، وليس ذاك الأب الذي عليك الاستماع لنصائحه وتعليماته، وليس تلك الأيقونة التي عليك اللهج بحِكَمها التي لا يطالها النقد، وليس ذاك الذي يقدم لك اليقين في كل ما تتساءل عنه، وباختصار أيضاً، ليس ذاك الموسوعي، صاحب جراب الحاوي.
كان مفكراً إشكالياً وسجالياً من الطراز الرفيع، وصاحب عقلية نقدية وعلمية جدالية، همّها تفكيك التابوات والولوج للأعماق المظلمة في الفكر والمجتمع الإنسانيين، لاستجلاء مكوّناتهما ورفع الحصانة عنهما. كان موضوعياً في نقده ورؤاه قدر الإمكان، حيث لا مكان للذات الباحثة عن المعنى والفعل في إسقاط تصورات مسبقة، حيادياً تجاه الظاهرة المجتمعية التي يحللها إلى حدّ ما، لأنه لا مجال للعواطف في تعرية الظواهر المجتمعية وتفكيكها، مشاكساً ومستفزاً ومبتكر أفكار، سواء للذات الباحثة والنهمة للحقيقة والمعرفة، أو للمستنقعة في مطلقاتها ويقينياتها على السواء.
كان “نكّاش دبابير” بالمصطلح العامي، فأينما وجد لا بدّ أن يحرّض “الأموات” على الخروج من القبور المصطنعة بمقاس الإيديولوجيات الشمولية آنذاك، والممهورة بخواتم القداسة والمحرّمات، ولا بد أن يُثوّر المستنقعات أو يصيبها بالاضطراب أو الهيجان، حيث لا مكان للسكون في عالم الحركة والتغير الدائمين.
الإشكالي المحرض
لم يتدرع العظم برداء الأكاديمي التقليدي، بل ارتقى بمفهومه وانتقل من فضاء الأكاديمي إلى الفضاءات الأخرى منذ الستينيات، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيينه كمدرس مساعد في الجامعة الأمريكية ببيروت، وبدت المدينة والجامعة أكثر تألقاً وتوهجاً وحيوية، سواء في محاضراته العامة التي كان يقدمها في النادي الثقافي العربي، من بينها محاضرتان نشرتا فيما بعد في كتابه “نقد الفكر الديني”، وهما “الثقافة العلمية وبؤس الفكر الديني” و”مأساة إبليس”، وتوّجهما بمراجعة نقدية لمؤتمر أقامه شارل مالك في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان: “الله والإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر”، ونشرها في جريدة النهار في شباط/فبراير 1967، تحت عنوان: “الله والإنسان في الجامعة الأمريكية”، و”القشة التي قصمت ظهر البعير” كانت بنشر كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، والذي كتبه في حرم الجامعة الأمريكية،.
فصدر قرار الجامعة بإعفائه من مهامه وعمله في الجامعة، وإثر ذلك قامت تظاهرات طلابية، أدّت لتعطيل التدريس ثلاثة أيام في كليات الجامعة كلها، بما فيها كلية الطب، وهذا يعتبر سابقة في حينه، كما أنه يعبر عن مدى التصاق الأستاذ الجامعي بالطلاب، ومدى قربه من فضاءاتهم بشكل خاص، وليس الأكاديمي فحسب.
بين دمشق وبيروت
هذا المشهد لن نشهده في جامعة دمشق، ليس لأن الدكتور العظم لم يخترق فضاءات الطلاب، يغوص في تجاربهم ويكون جزءاً منها، أو لأنه ترك مسافة أمان بين الأستاذ والطلاب، أو أبقى جدار الهيبة الأكاديمية حائطاً فاصلاً، أو مصطبة مرتفعة ومسورة، وإنما لأن فضائي المدينتين مختلفان ببساطة.
لكل من المدينتين بصمتها الخاصة التي لا تمحى في حياة ومسيرة وفكر صادق جلال العظم، وإن اعتبر نفسه دمشقياً شامياً بامتياز، إلا أن الفترة الزمنية التي عاش فيها في بيروت أكبر من تلك التي عاشها في دمشق. إضافة إلى أن المرحلة ما بين الخمسينيات وبداية السبعينيات، كانت مرحلة انتقالية استثنائية، من حيث الظرف الحضاري والسياسي للمنطقة، بدءاً من النزوع للتخلص من الإرث الاستعماري وذيوله المشرّشة في القاع الاجتماعي والسياسي، إلى صعود المدّ القومي والفكر الراديكالي والمقاومة الفلسطينية التي طغى فضاؤها على ما عداه، بغض النظر عن سياقاته وتأثيراتها على الشارع العربي وأنظمته.
كما كان لهزيمة 1967 وقعها المزلزل على كافة المستويات المجتمعية، من سياسية واقتصادية وفكرية وإيديولوجية، حيث تعرّت وتساقطت شعارات البطولة الدونكيشوتية والشعبوية، واتجه اهتمام صادق جلال العظم، كالعديد من المثقفين في تلك المرحلة، كسعد الله ونوس “حفلة سمر من أجل 5 حزيران”، ونزار قباني “هوامش على دفتر النكسة”… إلخ، إلى نزع ورقة التوت الأخيرة عن نظام عربي منخور حتى القاع، وتجلى ذلك في كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، ومن ثم انتقاله للعمل ضمن أطر المقاومة الفلسطينية، حيث ساهم في مركز الأبحاث التابع لها في بيروت، مع مجموعة من المثقفين، حاولوا فيها كسر جدار الوهم والغموض الذي بنته الأنظمة وإيديولوجياتها عن إسرائيل، والقيام بحركة تنويرية هدفت لمعرفة الأسباب الحقيقية الواقعية التي أدت للهزيمة.
إذ إن السياسات الرسمية العربية اتسمت بحالة مرضية نكوصية تجاه إسرائيل، من خلال منع وتحريم أي مقاربة أو دراسة أو ذكر لكل ما يتعلق بهذا الكيان، والتي استمرت إرهاصاتها حتى ما بعد التسعينيات. مرحلة طغت عليها هموم الهزيمة والمقاومة الفلسطينية وحرب الاستنزاف، أمضاها صادق في التنقل ما بين بيروت وعمّان ودمشق، حيث كان النشاط السياسي والفكري مهيمناً، راهناً جلّ طاقاته للمقاومة الفلسطينية، شأنه شأن العديد من المثقفين، وإن رافقه عمل أكاديمي خجول.
ففي منتصف 1968، درّس في الجامعة الأردنية لعدة أشهر، كانت كافية بالنسبة للسلطات الأردنية لوضعه على لائحة الممنوعين من دخول البلد، بعد ترحيله على طائرة مسافرة إلى بيروت. وفي نهاية العام 1969، انفجرت إشكالية كتابه “نقد الفكر الديني”، على خلفية تناوله وطرحه للعديد من القضايا المحرّم تناولها أو وضعها على بساط البحث، سواء بما يتعلق بالمؤسسة الدينية أو السياسية بالتحديد، وخلخلة ما هو سائد في الفضاء الاجتماعي العام الذي يهيمن عليه السياسي والديني بآن معاً.
هذا من جانب، ومن جانب آخر صدمة الهزيمة العسكرية لثلاثة جيوش عربية أمام الجيش الإسرائيلي، الذي أسقط الأقنعة التي تتستر بها المؤسسات السلطوية، من دينية وسياسية ومدنية، وحتى قضائية. وإثر ذلك، طلب مفتي الجمهورية اللبنانية بإحالة المؤلف والناشر والكتاب إلى المحاكم، كما طالب بتوقيف العظم، وليسجل مفارقة غير مسبوقة في تاريخ لبنان وسورية، وإن كانت مألوفة في السياق الحضاري العربي الإسلامي، حيث فرّ من لبنان إلى سورية، ومن ثم سلم نفسه للسلطات اللبنانية، بعد مفاوضات معها بشأن الكتاب، وأُوقف أسبوعاً على ذمة التحقيق.
في أواخر السبعينيات صدر له كتابان في بيروت وهما: “سياسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية” و”زيارة السادات وبؤس السلام العادل”، ومُنع الكتابان في سورية، ولفتا أنظار السلطات إليه، ما أدى لاعتكافه في بيته في بيروت، على الرغم من أنه كان يدرّس وقتها في كلية الآداب في جامعة دمشق.
وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبمبادرة من عميد كلية الآداب، حامد خليل، وصادق جلال العظم، رئيس قسم الفلسفة بجامعة دمشق، أقيمت فعاليات الأسبوع الثقافي في الجامعة، والذي بدا حينها حدثاً استثنائياً على أكثر من صعيد، في العاصمة دمشق المستنقعة بفعل الطوق الأمني في فضائها العام، والتي أُرهقت، على مدار عقدين من الزمن، بالعديد من حملات الاعتقال التي طالت نشطاء العمل السياسي والفكري حينذاك، ورواد الأسبوع الذين فاقوا كل التوقعات، ومن كل الشرائح الاجتماعية المتعطشة للحرية الفكرية.
طلاب ومثقفون وسياسيون أفرج عنهم النظام منذ بداية التسعينيات، والذين وجدوا في طروحات صادق العظم وكتبه المتنفس والنافذة المشرعة لفضاء جديد من الحرية طالما حلموا به، بعد حرمان مديد. ليجدوا في تلك الأسابيع نبضاً جديداً لم يستطع النظام تحمله لأكثر من خمس سنوات، ليعفي إثرها حامد خليل وصادق جلال العظم من عمليهما في الجامعة، ويكون ذلك بمثابة الرصاصة القاتلة للأسبوع الثقافي، ولكن ليس دون بذرة ستنمو في ربيع دمشق بعد عدة أعوام، والتي وأدها نظام العهد الجديد في المهد، مستنداً لإرث عريق في القمع وإسكات الصوت الآخر.
————————
صادق جلال العظم… الحبّ ضد الدونكيخوتيّة/ عمار المأمون
اتُهم صادق جلال العظم، حين نشر كتاب “في الحب والحب العذري” عام 1968، بأنه لم يتناول حياته الشخصية وتجاربه الغرامية، ردّ حينها: “لا يبدو لي أن تجاربي العاطفية الشخصية بهذه الأهمية لتستحق إقحامها على انتباه القارئ”، هناك سخرية دفينة وعلنية في ردود العظم على طفولية “النقد” الذي وُجِّه له.
هذه السخرية نراها أحياناً أثناء بنائه موضوعته الفلسفية ونقاشه لها في الكتاب السابق. هو عقلاني، ينفي بحسم ويقبل بحسم، ويتهكّم في بعض الأحيان، خصوصاً أنه يناقش موضوعاً عصيّاً على التعريف الدقيق، الحب: “أطياف من المشاعر والأحاسيس والانفعالات المتقاربة المتشابهة المترابطة ترابطاً عضوياً في النفس الإنسانية”.
لن نحاول أن نقدّم مراجعة للكتاب، لكن سنشير إلى النماذج التي يقدمها العظم عن “المُحبّ”، وتصوّراته عن الموضوعة البشرية “المُحبّة” وبنائها النفسي ضمن التراث الأدبي والنقدي، خصوصاً أنه يمتلك تصوراً عن الحب بوصفه أسمى من الجسدي، حباً يتجاوز الذات دون إفنائها أو تكبيلها.
إشكالية اللا اكتمال
تمتلك الموضوعة البشرية نقصاً أزلياً يحرك قلقاً يدفعها للبحث عن الاكتمال العاطفي أو الجسدي، هذه النزعة للامتلاء والانغلاق، واحد من أعراضها هو “الحب”، ليس ذلك الجنسي الشبقي الآني، بل الحب كمحرك للذات نحو “آخر”، يحاول خلق وهم الإشباع. يظهر الحب قلقاً وبحثاً عن مجهول لا نعرف شكله، هو سعي وظيفي بهدف الاتمام، المحبّ لا يبحث عن “قرين-double” بل “آخر-other”، يلبي احتياجات الذات.
بصورة أدق، يخاطب نقصانها بوهم خصائص الاكتمال فيه، وهنا يظهر تأثير الحب، الذي إن اشتدت أوهامه يهدد وعي الأنا بالعالم، فالعاشق حسب العظم، لا يرى سوى موضوع حبّه ويتجاوزه جنسياً: “أي أنه يكتسب نوعاً من المناعة ضد غيرها من النساء”.
بعيداً عن تفريق العظم وتعريفاته التي تفصل الحب عن الشبق، الشهوة والرغبة، هذه “المناعة” الذاتية تقسم الموجودات أنطولوجياً، إلى “محبوبة” وآخرين، وهنا تحتار الذات، وقد ترى نفسها آخرين أيضاً، اختلفت أعراضهم بسبب تحديقة المحبوبة التي قد لا تعلم نفسها أنها محبوبة، وهنا يمكن أن نفهم “العمى” الذي يوصف به الحب، هو ليس فقط يعمي عن حقيقة المحبوبة، بل أيضاً “عمه” عن إدراك الآخرين والسياق الذي يظهر فيه “الحب” وأسبابه الموضوعية.
إثر هذا العمى والعمه، يتحول بناء المحبوب إلى جهد سردي ومتخيّل “لا يتناسب تناسباً معقولاً أو موزوناً مع محاسن المحبوب وفضائله ومفاتنه”، وهنا يظهر النقصان مرة أخرى، الذي يبني الموضوعة الخارجية ويعبئها من المخيلة، ويكسبها خصائص متغيرة، تتناسب مع احتياجات الذات نفسها، سواء كانت مُحبة أو شبقية.
يقسم العظم محركات الحب الديناميكية إلى عاملين: الاستمرار في الزمن وشدة العواطف، ضمن ما يسميه مفارقة الحب، وكل واحدة من هذه المحركات تقدم لنا نموذجاً يطغى واحدهما على الآخر دون أن يجتمعا، فالاستمرار في الزمن والحس بالاستقرار الذي يلي نشوة الحب بداية، يتحول إثره العشيقان إلى زوج وزوجة، في حين أن الرهان على الثانية، أي شدة العواطف، تحول العشيق إلى دونجوان، والمعشوقة إلى غرض متغير بحسب ما يشتهيه المحب الشغوف، الذي لا يبحث عن الاستقرار بل عن المغامرة المتجددة.
الدونجوان ضد الزوج
يقدم لنا العظم نموذجين لعاطفة الحب، تتحول الأنا إثرهما في علاقتها مع الآخر ومع ذاتها، وتكمن المفارقة بين النموذجين “الدونجوان” و”الزوج”، أنه لا يمكن تحقيق الاثنين معاً، فالنموذج المتمثل بالدونجوان، يبحث إثره العشيق عن مغامرة. هو مندفع نحو موضوع حبّه المتغير دوماً، كونه يريد الحفاظ على الاشتداد، فينتقل بين عشيقة وأخرى.
هو ضد الامتداد في الزمن ويهزأ من المؤسسة الاجتماعية التي تنفيه بدورها وتحاربه. هو غاو متمرّن ومخطط محنك، موضوعة تسلم بالنقصان، تربيه وتدلـله، وتعلم أن لا يقين ولا اكتمال. هو باحث عن حب مجهول لا يقين لديه بالامتلاء، لأنه مدرك لذاته وتراجيديتها نوعاً ما، خصوصاً أن مصائر الدونجوان دوماً تنتهي بكونه وحيداً. وعلى النقيض، هناك نموذج الزوج والزوجة القانعين بالاستقرار، اللذين تتحول حياتهما إلى روتين يومي، يدركان وهم الاكتمال وحقيقة النقصان، مع ذلك يسلمان بالأمر الواقع، يحلمان بمغامرة عابرة لكنها تبقى طيّ المخيلة، وهنا تظهر المفارقة، سواء لدى الدونجوان أو الزوج المطيع، أن الاستدامة في الزمن ضد الشدة، تنفي أحداهما الأخرى.
هناك نهايات حتمية يقدّمها العظم للنموذجين، هو يستند إلى التراث العربي والأوربي، وينتقد القيود الموضوعة على الجسد وطبيعة مؤسسة الزواج بصورة لاذعة، ينتقد التفسيرات المرتبطة بهذه الظواهر والآراء الرجعية، كآراء العقاد، لكنه يرسم حدود الموضوعة ضمن الأدب، مسلماً بالتطابق بين النموذجين، ويصف المتوكل بالماجن، ويقتبس من ابن حزم الأندلسي وابن الجوزية دون مساءلة الأيديولوجيا.
هي دلائل نعم، لكنه لا يسائل السياسات وراءها، بل يقول في الرد على منتقديه إنه يرى الشعر والثقافة العربية كلاً متصلاً، هذا الاتصال لا ينفي طبيعة التأليف في كل عصر. هي منتجات شعبية وأعمال أدبيّة وأخرى تعليميّة، لكنها تقدم مُتخيّلاً عن صورة الحبيب.
هي ليست حكايات تاريخية، بل تراث شعري تحضر فيه المخيلة بأقصى أشكالها، وهذا ما نكتشفه لاحقاً حين يقدم للحب العذري وطبيعة هذا المفهوم، وهنا يظهر التبسيط الذي يعمل ضمنه العظم، هو يترك النماذج تصف ذاتها، لكنه لا يسائل كيفية تشكلها تاريخياً، الانتقال بين مراحل التاريخ والتسليم بمرجع على حساب آخر، خصوصاً أنه لا يضبط المرحلة الزمنية.
لا يظهر الدنجوان ثائراً من وجهة نظر العظم، بل معطوب نفسياً، ذو مشكلات، لا يرى فيها متخيلاً أدبياً عن العمل ضد المؤسسة الزوجية والاجتماعية، خصوصاً أنه يستثني اللذة بداية بحثه، ويرى أن الحب طاقة ذات أثر نفسي، هي تحررية شريطة أن تتحرر من موضوعها ذاته، الأهم أنه يقتبس من دونجوان موليير، الذي ظهر ضمن شروط قاسية، وضعتها الأكاديمية الفرنسية على موليير تحديداً الذي أراد محاربتها، فمصير دونجوان هو الجحيم، حيث تبتلعه الأرض لينال عقابه.
الحبيب العذري: ثائر ثم مريض
يقدم العظم صورة المحب العذري بوصفها أسلوباً لتجاوز أطروحة “مفارقة الحب”، فالمحب العذري هو المغرق في شغفه، الناسف سطوة الزمن عبر خلق العراقيل الذاتية والموضوعية أمام الوصال مع حبيبته، هو يحنّ للموت بوصفه فراقاً أزلياً، يشبب بالنساء ويرفض الزواج واللقاء لغاية “مَرَضية” في نفسه، هو المتهكّم من الزواج واللعوب أمام الناس.
الفضائحية المستخدمة في حالات الحب العذري هدفها منع الوصال أصلاً، فمَرَضية العذري أنه يراهن على اللا اكتمال، لا يريد الزمن أن يمتدّ ولا الشدّة أن تتلاشى. هو تدليل للمغامرة ومحاباة للممنوع، لأن هدف هذا الحب هو ألا يتحقق، وهذا ما يصفه العظم بالمَرَضي. الكلمة التي تبدو قاسية نوعاً ما، خصوصاً أننا نتعامل مع نماذج أدبية، وهنا يرى العظم أن العاشق العذري يحب حبه ذاته، موضوع عشقه هو معاناته ذاتها ورحلته في العشق، فأناه هي محرّك هذا العشق ولذته، حتى العطاء في سبيل الحب العذري هو وهمي، في سبيل نشوة التضحية وألمها. هو مازوخي يتلذذ بأذى نفسه.
الأهم أن المحب العذري عاشق دونكيشوتي، يعيش حبه في حلمه ويعيد تعريف الواقع بناء على شهواته، يفضل المرأة الخجولة المختفية الجاهلة على العارفة اللعوب التي تكشف حقيقته وتنفيه، وتحرج كبرياءه إن طالبته بواجباته، هو يريد دمية لا يريد شخصاً حياً، لذلك هو غير سوي.
شعريات النقصان والتلاشي
يتهم العظم الحبيب العذري بالنفاق، النرجسية، المرضية، الدونكيشوتية والفضائحية. هو منحط في لحظة ما، لكن هذه الأوصاف الحاسمة ينتقل فيها العظم بين التبرير النفسي وذاك الاجتماعي، لكن كلمة مَرَضَي ذاتها دون معنى، خصوصاً أن العاشق العذري، إن سلّمنا بكلام العظم عن رفضه لـ”مفارقة الحب”، هو الأشد شجاعة، هو ذات تؤمن بنقصها وتدركه، وتمعن في الحفر عميقاً حد الاختفاء.
يعيب العظم على العذري علاقته مع السلطة الاجتماعية وخياراته الشخصية، علماً أنه يحب الحب ذاته، يتمسّك بالعاطفة متحدياً حتى الرغبة بالاستمرار في الزمن و تقلّبات الشدة، هو مؤمن من وجهة النظر هذه بأن لا خلاص من “جهاده” ضد الاكتمال، مسلّم بالنقصان، لكن الأحكام النفسية التي يطلقها العظم والصفات والتفضيلات والسخرية تظهر قاسية، خصوصاً فيما يتعلق بخيار المحب العذري للنساء المستضعفات.
الأهم، العاشق العذري واع بذاته، شهواته متغيّرة لكنها لا تحيده عن العشيقة التي لا يمكن له نوالها. هذا الوعي والاختلاف بين الشهوة العابرة والحب المستحيل، يجعل العشيق العذري مغامراً ولو كان دونكيشوتياً. هناك وعي ذاتي ومخاطرة، خوضها ذاته هو ما يحوي المتعة التي تحاك الحكايات حولها، وهنا يمكن النظر إلى الحب العذري نفسه بوصفه محركاً أدبياً، الحبيب فيه موضوعة تولّد الشعر وتفتح المخيلة، أما القراءة النفسية والحرفية للأخبار الأدبية، فتنفي مفاهيم اللعب والتسلية والمخيلة الشعرية والحكاية الشعبية.
استحالة الحب بين العشاق العذريين، تعكس استحالة حب الذات التي تدرك نقصانها، هي تبذل وتبذل كي تحافظ على ديناميكيّة بقائها، هي تحتاج موضوعاً خارجياً ولو مستحيلاً في سبيل استمرارها في الزمن، لا كـ”عشيق/ عشيقة”، بل كفرد استعراضي، وهنا أزمة العاشق العذري إن أردنا مخالفة العظم، هو يبحث عن العلني والفضائحي، كي يبقى أسير الألسنة والحكايات، لا كرهاً في ذاته، بل إمعاناً في الظهور، لكونه هو نفسه موضوع عشق لمجاهيل لا يعرفهم، يرددون حكاياته وأخباره.
————–
لماذا نقرأ صادق جلال العظم اليوم؟/ فجر حدد
يوصف الدكتور صادق جلال العظم بأنه “مفكّر إشكالي”، ويقصد بهذه التسمية عند أنصار الفكر الديني والإيديولوجيا الغيبية أنه معاد للغيبيات وتفسير العالم، وخصوصاً الهزيمة العربية، بأنها امتحانات إلهية سقطنا فيها ويجب قبولها كما هي، بينما هو مفكّر شديد الالتصاق بقضايا أمته، أثار عاصفة جدلية لأنه لم يرض بما رضي به الباقون، ووقف علانية في وجه مروجي الفكر الغيبي كما في وجه الطغاة، ودافع بقوة عن حرية الرأي وقدّم تحليلاً موضوعياً للأسباب التي أدت إلى هزيمة 1967، والنتائج التي تلتها في المجتمع العربي.
وبالتالي، من الضروري للغاية إعادة قراءة ما قدمه الدكتور العظم من تحليلات حالياً خصوصاً بعد ثورات “الربيع العربي” الموءودة، التي فشلت بسبب ركوبها مركب الأسلمة والتطرّف، وقادت إلى كوارث محققة من إعادة إنتاج الأنظمة السابقة أو إلى مجازر لمّا تنته بعد.
مازلنا بحاجة إلى صادق جلال العظم ليظهر لنا كيف أن ثورات شعوب عانت من الطغيان لأكثر من 50 عاماً فشلت في إنتاج نظم جديدة تحترم الإنسان وحقه في التعبير والاعتقاد، مازلنا بحاجته لنرى أسباب “هزيمتنا” الجديدة في ميدان الثورات، ولنشاهد بأم العين عبر مرآة “نقده الذاتي” شخصية “الفهلوي” الذي يظن أنه بشعار مستلب من بطن الكتب الإسلامية وببندقية مستأجرة من دولة أخرى يستطيع أن ينجز ثورة ضد واحد من أعتى الأنظمة في العصر الحديث، وعلى الجانب الآخر الذي لا يختلف عنه، “الفهلوي” في السلطة الذي يظن أنه عبر ادعاء البراءة والمظلومية يستطيع أن يهرب من غضب الشعوب ومن جرائمه العديدة التي ارتكبها نظامه.
مازلنا بحاجة لفكره النقدي الذي دشّنه بالنقد الذاتي والذي لا يعتبر “عادة عربية” أصيلة، إذ لا يعترف أحد بمسؤوليته عما آلت إليه الأمور، ولماذا فشلت أنظمة “القومية العربية” في إنجاز تحديث الدولة والمجتمع، ومن بعدها، لماذا فشلت ثورات الربيع العربي في الهروب من حفرة العسكرة والتطيّف.
الدكتور العظم الذي لم يكف عن إثارة الماء الراكد والآسن عبر حياته الفكرية كان، ورغم إقامته خارج بلده سورية، يرفض أن يتعالى على واقع بيئته، وكان شديد القرب منها، يتحدى طغاتها ويفنّد مقولات “علمائها”، محافظاً على حريته وحرية غيره بالتغيّر والتغيير وإبداء الرأي.
مات في برلين لكن عقله النقدي مازال يعيش في دمشق، متنفساً هواءها ومدافعاً عن حقها في التنفّس والحرية.
أبرز مؤلفات الدكتور صادق جلال العظم
النقد الذاتي بعد الهزيمة
يعتبر هذا الكتاب أحد أهم الكتب التي صدرت بعد هزيمة 1967، التي هزّت العالم العربي، وفيه يبحث الدكتور العظم في أسبابها ونتائجها، ويقدم تحليله للآراء التي سادت بعد الهزيمة لبعض المفكرين العرب.
وأعيدت طباعته عدة مرات آخرها في عام 2007، ذلك أن بعض ما جاء فيه يمكن أن يشكل درساً مهماً للأجيال المعاصرة لترى أين تقف من العالم وأين يقف العالم منها.
كتاب “نقد الفكر الديني” 1969
في هذا الكتاب يتناول الدكتور العظم الصراع بين العلم والدين، ويظهر أن الأديان بنيت على أساطير مكررة لا تصلح لتفسير العالم ولا لتهيئته كمكان صالح للعيش.
ويؤكد على أهمية الفكر العقلاني العلماني الذي يبتعد عن الغيبيات ويحفظ حريات الناس ويبنى الدول.
كتاب “في الحب والحب العذري” 1981
يعالج الدكتور العظم بعض الأوهام الاجتماعية السائدة في العالم العربي حول دور المشاعر في الحياة اليومية، وينتقد الأعراف الاجتماعية التي أدت لسيادة أساطير تتعلّق بالخوف من الحب والجنس، ويدافع عن حق المرأة بتقرير حياتها وامتلاكها لجسدها.
كتاب “ذهنية التحريم” 1992
ينتقد العظم في هذا الكتاب في قسمه الأول في هذا الكتاب نظرة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد للاستشراق الغربي الذي يرى أن هناك طبيعة واحدة ثابتة للشعوب العربية مقابل طبيعة أخرى ثابتة للشعوب الغربية وهذا التمايز ثابت وغير قابل للتغيير، ويضيف الدكتور العظم وجهة نظره حول وجود هذا الاستشراق عند مفكري الشرق أيضاً بطريقة معكوسة، كإدوارد سعيد نفسه.
وفي قسمه الثاني يخوض دفاعاً شرساً عن رواية سلمان رشدي ” آيات شيطانية” وفتاوى التحريم والدعوة إلى قتل الكاتب التي صدرت من مرجعيتين متنافستين، شيعية وسنية في العالم الإسلامي.
——————————-
مأساة إبليس… مأساة العاشق ورجل الظلّ/ محمد دريوس
وحش ذو قرون وحوافر، بوجه عنزة أحياناً، وأحياناً أخرى ظلام على شكل سحابة سوداء تسير بخفة تخترق الأجساد لتتحكم بأصحابها وتجبرهم على فعل مالا يرغبون بفعله. هذه فقط صور قليلة للشيطان الذي يتخذ أشكالاً وأسماء مختلفة، حسب موقعك الثقافي والديني، وسواء أكنت مهتماً بالدين أم لا، تعزى الخطايا جميعها لعبث الشيطان وألاعيبه، أبي الأكاذيب والغواية والخطيئة الأولى.
الولد السيء
بالرغم من أن صورة الشيطان بأغلبها مصنوعة من الأدب، أي من التصورات الخيالية الممزوجة بالإيمان اللاهوتي، لم يفشل الشيطان بأن يكون مصدر وحي لا ينضب.
سواء أكنا نؤمن بوجود الكيان المجسّد للشرّ الروحي أم لا، لكننا نبدي اهتماماً شديداً بصورته الأدبية والواقعية أيضاً، ونستخدمها على نحو متكرر: الطفل الذي يرنّ الجرس ويهرب، عشر مرت في اليوم الواحد، ناظر المدرسة الذي يضرب على أضابع التلاميذ في الشتاء، ساعي البريد الذي تسقط منه الرسائل سهواً، الأخ الأكبر، الوالد المدمن على الكحول، الشرطي الفاسد، رجل السلطة الساعي للحرب، كلها صور تنتاب البشر في لحظات ما ويصنعون من خلالها شخصية خيالية كاملة للشيطان، وبدون هذه الشخصية لن يعود هناك أدب على الإطلاق، إذ ستفقد اللغة نصف مفرداتها على الأقل، وتصبح “معقمة”.
لم يذكر العهد القديم الشيطان سوى بصورة غامضة، كان تابعاً ليهوه وكان دوره هو اختبار إيمان البشر، كمساعد سري للرب، لكن العهد الجديد هو من أعطاه دور البطولة، وسمح له بإخضاع الناس للـ “تجربة”، وكان مسؤولاً عن العديد من الأوبئة، ثم أصبح حاكم العالم لمدة 1000 عام قبل ولادة المخلّص يسوع.
ثم جاء الإسلام ليروي القصّة المعروفة عن عصيانه لأمر الله بالسجود لآدم، وليعتبره مسؤولاً عن الخطيئة الأولى، التهام تفاحة المعرفة التي حرم الله أكلها، والتي تفرعت عنها كل الشرور والخطايا اللاحقة، وهذا ما سنتكلم عنه لاحقاً.
لكن في العهدين القديم والجديد يظهر الشيطان كبطل ملحمي ورمز للتمرّد، وهذا ما جعل الأدباء يتخذونه مثالاً لما يمكن أن يكون عليه الشخص الفوضوي، المنتهك، الذي لا يخضع للقوانين السائدة ولا يلتزم بأخلاق، بغضّ النظر عن القيمة الحقيقية للتمرد المقصود هذا، كما عند الشاعر الإنكليزي وليم بليك، حيث خفف هذا الحضور التراجيدي لبطل من هذا النوع من “آثام البشرية”، إذ أعفي البشر، وخصوصاً السلطات، من تبعات آثامهم بإلقائها على الشيطان الذي يوسوس ويعقد اتفاقات شيطانية ويشتري أرواح الناس مقابل وهم بالخلود أو النجاح أو الفرار من أزمة.
وكان، في مرحلة ما، رمزاً ثورياً للخلاص من الملكية والإيمان بقيم الجمهورية، إذ رأى جون ميلتون (1608-1674)، الشاعر والكاتب الإنجليزي، فيه متمرداً على التفاوت الكبير في الرتب والقيمة لصالح الرب، على عكس دانته، الذي حمّله عيوب المجتمع كاملة، ويكاد ميلتون أن يعتبره شهيد مواجهة الاستبداد وعدم الخضوع، فتحمّل عذابه السرمدي بصبر، إذ “حمل صليبه” كما يجدر بنبي شجاع.
كما يُظهر الشيطان عند ميلتون في ملحمته الشعرية “الفردوس المفقود”، الفشل الذريع لفكرة الرب عن العالم، أو على الأقل هذه النسخة رديئة الصنع منه، إذ إن وجود الفجوة الهائلة المتمثلة بالشيطان تظهر فشل خطة الرب المثالية، واستحالة الخير الأبدي، ولا يمنح الإيمان بالله الخلاص ببساطة، لاستحالته.
يقول الرب ذلك بوضوح إذا أحضرنا ما صنعته يداه إلى طاولة التشريح وتساءلنا عن جدوى “صنعه”، في وقت كان بإمكانه الخلاص من كل الشرور والآثام دفعة واحدة.
هذه الفجوة المتمثلة بفشل “مشروع الرب” في العهدين القديم والجديد، وجد لها الإسلام حلاً وهو ما ناقشه الدكتور صادق جلال العظم في كتابه “نقد الفكر الديني”، في الفصل المعنون بـ “مأساة إبليس”.
مأساة إبليس
في كل منظومة سلطوية، معرفية أو سياسية، ثمة نظرية “الشخص الثاني”، أو الرجل الواجهة، الذي يمثل الوجه القبيح لهذه السلطة، والاثنان معاً يقومان بلعب أدوار مخطط لها ومدروسة مسبقاً، كلعبة “الشرطي السيء والشرطي الجيد” التي تظهر في الأفلام الأميركية. أحدهما يمثل الوجه القبيح الذي مهمته تحطيم أعصابك وسحقك، ليأتي الآخر ويقدم لك صداقته مقابل اعترافك بجرمك، وهذه اللعبة على المستوى السياسي نجدها كثيراً في الأنظمة الفردية المتسلطة، حيث تروج فكرة أن الرئيس شخص جيد لكن المحيطين به لا ينفذون تعاليمه كما يملي عليهم.
على مستوى الأساطير الدينية لعب الشيطان هذا الدور، دور رجل السلطة السيء الذي يدفعك إلى المعصية والخطيئة، بينما ينتظرك الرب، هناك، تحت شجرة التوبة الوارفة، لتعلن ولاءك له والتبرّؤ من الشيطان الذي يظهر هنا كعدو للرب، بينما هو موظف لا غير.
هذه الفكرة نفسها، يقدمها المفكر صادق جلال العظم في “مأساة إبليس” التي جعلته بطلاً تراجيدياً مخلصاً لخالقه لكنه مكروه من عباد خالقه، فهو وقع في تناقض فرضه التعارض بين الأمر الإلهي والمشيئة الإلهية، كما يشرح العظم، فعصيانه محسوب بدقة، وإلا ما كانت الخليقة أصلاً ولانتفت الحاجة إلى الأنبياء والرسل والكتب المقدسة، ولفقدت “خطة” الرب جدواها ومعناها أيضاً.
يسمي الدكتور العظم التناقض الذي وجد إبليس نفسه فيه بالـ “غربة”، ويورد مقطعاً للقطب الصوفي الحلاج، على لسان إبليس، يصف فيه عذاباته: “أفردني، أوحدني، حيّرني، طردني لئلا أختلط مع المخلصين، مانعني عن الأغيار لغيرتي، غيرني لحيرتي، حيرني لغربتي، حرمني لصحبتي، قبحني لمدحتي، أحرمني لهجرتي، هجرني لمكاشفتي، كشفني لوصلتي…”.
في هذا المقطع الذي يبدو كنوع من عتاب المحبين أكثر من تمرد الأشرار وكرسالة عاشق متبتل أكثر من زعيم للشرّ المطلق، نجد الحلّ الذي فشلت المسيحية واليهودية في سد فجوته: الشيطان عبد مخلص، بل هو أكثر إخلاصاً من باقي الملائكة والرسل، وقام بتضحية عظيمة خضوعاً لمشيئة الرب وهو يعلم أن عاقبتها وخيمة وأبدية، ولهذا يطلق عليها لقب تراجيدي خاص بمأساة فريدة لعاشق فريد.
إذن، كما استخلص الدكتور العظم، الأمر ليس بالبساطة التي ذكرتها النصوص القرآنية من “عصيان” الأمر الإلهي، والتبجّح بتفوق عنصر النار على الطين، ولا حتى بالنزول إلى المستوى الثاني من التأويل كصراع بين الخير والشر، بل هي محنة مكتملة واختيار مصير أبدي بعينين مفتوحتين، واسترضاء للخالق الذي أمر بشيء وشاء بعكسه، وأيضاً هي اعتراف بقدرة الله على الخلق، إذ إن الله هو من صنع هذه التراتبية بأفضلية عنصر على آخر، ومن يكون الشيطان البائس، ليعكس هذه الحقيقة؟
هل انتهت القصة بطرد الله لآدم وحواء ومن الجنة وطرد إبليس نتيجة عصيانه؟ لا، إذ يبدو العقاب الإلهي المطبق على إبليس نوعاً من المكافأة المغطاة بثوب العقاب، مكافأة على ولائه الذي لا تشوبه شائبة ومأساته التي تحمّلها بشجاعة المخلصين.
أعطاه الرب ملكوت الأرض والسماح بممارسة هوايته المحببة بإغواء البشر وتقديمهم قرابين للرضا الإلهي، لتلميع صورته كرب رحيم يقبل التوبة أو كرب غاضب لا يسامح على معصية، وفي هذا نوع من المكافأة الخفية وليس العقوبة القاسية.
بل كما يذكر الدكتور العظم، إن الصفات التي أسبغت على إبليس أعطته، من حيث لا تدري، قوى خلاقة ومبدعة تثير الإعجاب: “فعلى سبيل المثال يعزو ابن الجوزي معظم الحركات الدينية والفكرية الكبرى التي قامت في تاريخ الحضارة الإسلامية إلى إبليس ويجعله مسؤولاً عنها، فيحوله إلى فيلسوف كبير ومتكلم قدير”، حسب ما جاء في كتاب “تلبيس إبليس”، كما أن وجوده المتعدد عبر نسله الذي لا يحصى ولا يمكن أن يفنى يضفي عليه المزيد من القدرة الخارقة، رغم الصور المشوّهة التي أوردها الفقهاء حول طريقة تناسله وكيفية دخوله لأجساد البشر.
الولاء والعودة
قانون المحنة المسيحي والإسلامي يعمل على نحو مأساوي في حالة إبليس وحالة المسيح أيضاً، فالمحنة والاختبار هنا ضرورة ميتافيزيقية لا يمكن التهرّب منها دون أن تنفي نفسك، وتدمّر إيمانك، المأساة هنا أننا لا تستطيع التفريق بين الإلهي والشيطاني، بل يندمجان معاً، ما يجعل الإنسان ضحية معاناة مستمرة، بينما أعان الله محمداً على “شيطانه” عبر نزع “البذرة السوداء” من قلب النبي، من قبل جبريل في المرة الأولى، ثم عبر إجباره على اعتناق الإسلام، كما ورد في الحديث.
ويمكن النظر إلى المأساوي ككائن محكوم بالتدمير أو الكائن الذي يهدده التدمير في كل لحظة، لذلك لا يستطيع إبليس الذي تغير اسمه إلى الشيطان، بنوع من التلطيف اللغوي إلى حد ما، أن يكف عن القتال للحظة واحدة، أن يتوقف ويقول: لم أعد أستسيغ هذه التراجيديا المملة، أريد أن أذهب إلى البيت… لا يستطيع أن يكون سلبياً، أو حتى أن يتوب ويتحول إلى فعل الأشياء الخيرة، هو محكوم بالاستفزاز المستمر والمعاناة الدائمة، ولا يستطيع فكاكاً من وعده بالولاء ولا بالكفّ عن “التمثيل” والتحول إلى ملاك عادي، يسبح بحمد خالقه ويشكره.
كان إبليس رفيقاً أزلياً للرب، كان يعرف أكثر من أي ملاك آخر مقاصده وخططه وطبيعة قراراته، وارتضى، بما يشبه التواطؤ عير المعلن، الصورة القبيحة التي منحت له لإنفاذ مشيئة الرب، ليبقى وجه الرب نقياً كما يجدر به أن يكون، وهنا تكمن مأساته الأزلية.
—————————–
صادق جلال العظم… مزايا الأدب ومعارضة المقدس/ علاء رشيدي
أوسع نصوص صادق جلال العظم، الذي تتجلّى فيه نظريته في النقد الأدبي والفني بوضوح واستفاضة أمام القارئ، هي دراسته المعنونة “سلمان رشدي وحقيقة الأدب” من كتابه “ذهنية التحريم، 1994″، التي تتضمن بالإضافة للدفاع عن سلمان رشدي، رؤية العظم للفن الروائي ودوره وتقنياته، مستشهداً بالعديد من الأعمال الأدبية والفنية التي تعبر عن رؤيته ونظريته في الأدب، والتي يمكن أن نحدد محاورها الأساسية في العناوين التالية: الأدب التخييلي أو الفانتازي، الأدب النقدي، أدب الالتزام، الأدب الوجودي، أدب معارضة المقدس وأدب التهكم.
ابتكار التخييل من تقنيات الفن الأدبي
يدافع العظم بشدة عن التقنيات التخييلية في الرواية، ويؤكد على ضرورة التمييز بين الروائي الأديب وبين المؤرخ. فالأدب باعتباره قائماً على التخييل، لا يمكن إخضاعه لمعايير نقد الدراسات وكتب التاريخ. وأطلق العظم للأديب حرية إعمال الخيال في التأليف القصصي والروائي، لنراه أيضاً يدافع عن الجانب الفانتازي للعمل الأدبي، الجانب العجائبي أو الما فوق طبيعي، على اعتبار أن الحدث الروائي ليس حدثاً منطقياً أو خاضعاً للشروط الفيزيائية، بل إن الخيال الروائي عُرِفَ بعلاقته مع الفانتازية، وبتوظيفه للخوارق والما فوق طبيعي في سبيل معالجة موضوعاته وتصوير حكاياته بطريقة فنية.
واستشهد بمقولة شكسبير: “إن أصدق الشعر أكثره اختلاقاً”، ومن الأدب العربي استشهد بمسرحية “يا طالع الشجرة، توفيق الحكيم”، كنموذج على المقدار الذي يمكن أن تبلغه الفانتازيا والتخييل في العمل الأدبي، وكذلك بين دور الفانتازيا وفوق الواقعي في الأساطير والحكايات الدينية ومنها قصة الإسراء والمعراج.
وفي هذا الإطار، يشدد العظم على حق الروائي في خلق عوالمه وأجوائه، والاستقلال النوعي بين مهمة الأديب كمبتكر للتخييل، وبين مهمة المؤرخ المدقق في صحة الأحداث الروائية كواقعة تاريخية: “تكمن المشكلة في أن المتهجمين العرب على رواية ‘الآيات الشيطانية’ عالجوا موضوعهم وكأن الروائي رشدي، يجب أن يكون فقيهاً وعالماً ومؤرخاً ومحققاً ولاهوتياً وواعظاً وعالم منطق، بدلاً من أن يكون فناناً وأديباً وروائياً”. هذه الرؤية عند العظم تسعى للفصل بين تقنيات الأدب وتقنيات التوثيق التاريخي.
الأدب الناقد للشرق وروحانياته
الأدب الذي اهتم به العظم هو ذلك الأدب القادر على نقد الثقافة التي يندرج في إطارها، فركّز على الأدب الذي ينتقد الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات التي يكتب عنها، واهتم بأدب دول العالم الثالث الذي ينتقد السلطات الدينية والسياسية فيها، يكتب في ذلك: “أدب سلمان رشدي يسعى إلى نقد الشرق وليس إلى التغني بروحانيته”. فأعجب بكتاباته التي تسخر بقوة من رغبة الغرب في الحفاظ على الصورة النمطية للشرق الروحاني، العجائبي والاستبدادي.
إذن، يقدم العظم لأدب شرقي يسعى إلى تحرير الشرق من جهله، أساطيره وخرافاته، ديكتاتوريته العسكرية، حروبه الطائفية والمذهبية وهامشيته الكاملة في الحياة المعاصرة، وأعطى أمثلة على هذا النوع من الأدب كتاب “المنتخب من اللزوميات: نقد الدولة والدين والناس، أبو العلاء المعري” ورواية “حكاية بلا بداية ولا نهاية، نجيب محفوظ”.
الأدب وقضايا المهمّشين والمهاجرين
لقد شدد العظم على ضرورة الارتباط بين الأدب والقضايا السياسية والاجتماعية، وبالتالي الإنسانية عامة. لقد أضاء على جوانب من أدب رشدي التي تتناول مشكلات الطبقية، ما أسماه رشدي نفسه بالصراع بين الطبقات والجماهير Masses and Classes، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطبقات في الهند تحمل معنى إضافياً لمعناه المعروف، أي التراتبية المشهورة للطبقات المغلقة وهرمها الصلد، الذي يقبع في أسفله المنبوذون ويتربع على عرشه البراهمة.
كذلك اعتبر العظم أن التصدي لفكر الحركات الإسلامية الأصولية المتشددة واحداً من موضوعات أدب الالتزام الأساسية في المرحلة الحالية، سواء كان ذلك في العالم العربي أو في الهند أو حتى في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأكد العظم، كما في كتاباته السياسية والفلسفية، على العلمانية كمنهج يجب للأدب أن يدافع عنه.
كما اهتم بذلك الجانب في أدب رشدي المخصّص لعكس قضايا المهاجرين في الدول الأوروبية وأميركا، وصنّف معالجة رشدي لهذه المسألة بالمعالجة العميقة والعارفة بتفاصيل العلاقة الثقافية بين المهاجرين وثقافات دول المهجر وحقوقهم فيها، فقد عالج المسائل الجوهرية والأسئلة المصيرية الكبيرة حول أوضاع جاليات المهاجرين الآسيويين من أصول هندية أو باكستانية أو بنغالية، في بريطانيا على العموم، وفي لندن على الخصوص، وكيف يرسم الأقوى صورة الأضعف ثقافياً ويفرضها عليه، وذكر العظم أعمالاً أدبية عالجت موضوعة الصورة المفروضة على الأضعف ثقافياً، كما هو الحال في مسرحيتي “الزنوج، الخادمات، جان جينيه”.
لقد أدان كل من العظم ورشدي معاً انسحاب الأدب من صراعات التاريخ وقضايا السياسة ومتاعب حمل القضايا الإنسانية، فكلاهما ينفيان بقوة وجود الأعمال الفنية خارج سياق الإطار الاجتماعي والسياسي، لأن لكل نص سياق، ويستشهد العظم بما كتبه رشدي في كتابه “أوطان خيالية”: “إذا ترك الكتّاب مهمة رسم العالم لرجالات السياسة، سيقترفون بذلك واحداً من أكثر أعمال الاستسلام خسة في التاريخ”.
أدب الأسئلة الوجودية بين الإيمان والشك
نكتشف ميل العظم إلى الأدب الوجودي من خلال تركيزه على فقرات من رواية “آيات شيطانية” تلك التي تحوي على صراعات وجودية بين شخصية ماهوند الرئيسية في الرواية وبين الملاك جبريل، وأيضاً في حكاية صراع سلمان الفارسي بين الإيمان والشك. كما ركز على العديد من الأسئلة الوجودية التي تتعلق بالإيمان والإلحاد في قصص الديانات وفي الأدب والرواية.
وقد ذكر في هذا السياق حكاية صراع يعقوب مع الله في سفر التكوين في التوراة، وحكاية “فاوست” لغوته في صراعاته وأسئلته الوجودية والماورائية، وكذلك شخصية “جبلاوي” في رواية “أولاد حارتنا” لنجيب محفوظ، وكذلك أورد في نصه هذا المقطع الذي يجسد فكرة الصراع الوجودي في أدب اليوناني نيكوس كازانتزاكس، من كتابه “تقرير إلى غريكو:
– أما تزال تتصارع مع الشيطان يا أب مكاريوس؟
– ليس بعد يا بني، لقد شخت الآن، وهو الآخر قد شاخ معي، لم تعد لديه القوة. إنني أتصارع مع الله.
– مع الله؟ وهل تأمل أن تنتصر؟
– إنني آمل أن أُلا أُهزَم يا بني. ماتزال عظامي معي وهي التي تستمر في المقاومة.
أدب معارضة المقدس
استتباعاً لأدب الالتزام السياسي وأدب الأسئلة الوجودية، اعتبر العظم أن الأعمال الأدبية الكبرى دوماً ما تسعى لطرح الأسئلة حول قدرة الإنسان على العيش دون الله، والأسئلة حول الإيمان والإلحاد، والموضوعات التي تتناول المقدس بالشك والمساءلة، وفي الأدب العربي يعطي أمثلة كتب “كتاب مفاخرة الجواري والغلمان، الجاحظ” الذي اعتبره معارضة ساخرة للمقدس، وكذلك ما ورد في معارضة المقدس من قصائد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وكذلك مقامات “ابن نافيا”، وضَمّنَ نصه العديد من القصائد الشعرية لأبي العلاء المعري التي كتبت في معارضة المقدس:
إن نص العظم هذا يعتبر مرجعاً للباحثين عن الأعمال الشعرية الأدبية العربية والإسلامية في معارضة المقدس، فيكتب في ذلك: “إن كلاً من مسيلمة الكذاب وابن المقفع وابن الراوندي والمتبني وأبي العلاء المعري قد عارض القرآن أدبياً على طريقته الخاصة”، وفي هذا الإطار، رفض العظم أي وصاية فكرية على الأعمال الفنية أو البحثية التي تعارض المقدس، واتهم النقاد العرب بتطبيق دور الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بدلاً من الدفاع عن حرية التعبير وحق الكاتب في المساءلة والشك، مذكراً بالرقابة التي مارستها الثقافة العربية على كتب مثل “الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبد الرزاق، “في الشعر الجاهلي” لطه حسين، و”نقد الفكر الديني” للمؤلف نفسه، وكذلك الهجوم التي تعرض له كتاب جريئون مثل نجيب محفوظ، محمد أحمد، عبد الله العلايلي، محمود محمد طه وحمود العودي.
أكد العظم بعد دراسته لأدب سلمان رشدي، أن العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى حداثة العقل والعلم والتقدم والثورة، بدلاً من أصالة الدين والشرع والتراث والرجعية، فالمسألة التي على الأدب أن يواجهها اليوم هي “كيف نبني عالماً جديداً وحديثاً من حضارة قديمة تسكنها الخرافة؟، وإن إعادة وصف العالم من جانب الروائي تشكل الخطوة الضرورية باتجاه تغيير هذا العالم. وبالتالي رأى أن على الأدب أن يسهم في فتح آفاق نقدية جديدة أمام الوعي الإسلامي والثقافي والتاريخي المعاصر، بهدم الأسوار التي تعيق تفتحه وإزاحة العقبات التي تقف حائلاً أمام تطوره ونموه. لقد دخل رشدي في عقل التشكيلة المعرفية الإسلامية القديمة وأمعن النظر في محتوياته فوجده فارغاً من كل ماله علاقة بالعالم الحديث حقاً، ومن كل ما هو مهم وحاسم بالنسبة للاستمرار والنمو والتقدم في المرحلة التاريخية المعاصرة”.
الأدب التهكمي الساخر
يقدم لنا العظم العديد من المرجعيات الأدبية في التاريخ، كشواهد على نوع الأدب التهكمي الساخر، منهم رابليه، فولتير، جويس وبريخت، في إطار إثباته لأهمية الأدب الساخر، والذي يطلق عليه “أدب الهجاء التنويري، أدب نقد الزمن والمجتمع والمحيط الثقافي بغرض التحريض والصدم والإيقاظ والتحريك والتغيير والتجديد وطرح البدائل”. ويعدد العظم تقنيات وأساليب الأدب الساخر من ألاعيب الضحك والفكاهة ومداعبات التهكم والاستهزاء وأحابيل المبالغة والتشويه والشطح، معتبراً إياها أدوات ووسائل يستعملها الأدباء لفضح حقائق عتيقة وموروثة، وتعرية وقائع مهترئة لا مصلحة لقوى التسلط البالي والسيطرة في انكشاف حقيقتها.
لقد فند العظم تقنيات الأدب الساخر الذي يجمع بين كتّاب مفضلين لديه مثل رابليه ورشدي، ومنها: “إحلاس الدنس محل المقدس وبالعكس، خلط السخيف بالجليل، الدمج بين الجميل والقبيح، شبك الأرضي بالسماوي، المزج بين الورع والفاجر، بين العفيف والفاحش. وذلك بغرض وضع علامة سؤال كبرى على المفروض إيديولوجياً والموروث تقليدياً. أي بغرض طرح السؤال الكبير حول مدى نفع معايير مستمدة من عصور سابقة أخرى وتجارب تاريخية ماضية”.
إن الأدب الساخر برأي العظم “لا يسعى عبر هجائه وسخريته إلى تكريس اليأس والقنوط أو تجميل العدمية المطلقة، وعليه ألا يقع في مطبات الوعظ والتعليم والدغمائية والأخلاقوية والإيديولوجيا، بل الأدب الساخر يُنتِجُ في عقل القارئ الريبية الإيجابية، أي الريبية النقدية البناءة، وهو الأدب القادر على إثارة الشك حول معايير العالم الموضوعي والواقعي والأخلاقي والعقلاني الذي نعيش في إثره، أي تنفضح كم هي مصطنعة واقعية هذا العالم الواقعي، وكم هي مخادعة موضوعية هذا العالم الموضوعي، وكم هي زائفة أخلاقية هذا العالم الأخلاقي، وكم هي لاعقلانية عقلانية هذا العالم العقلاني”.
دور النقد الأدبي
إشارة أخيرة إلى ما ورد في نص صادق جلال العظم عن دور النقد الأدبي. فقد هاجم النقادَ الذين يضعون أنفسهم أوصياء على القارئ، مدافعاً عن النقد الذي يستعرض للقارئ العمل الأدبي دون أحكام قيمة، ورأى أن على الناقد إفساح ما أمكنه المجال ليكوّن القارئ، بنفسه ولنفسه، الحكم الراغب فيه حيال العمل الأدبي. واعتبر أن مهمة الناقد هو التفكير، القراءة، البحث في الكتاب للوصول إلى الاجتهاد في القراءة النقدية الأدبية ورفض النقد القائم على البديهة والارتجال ورجز الكلام، والذي يسعى إلى المعاني المرسلة والألفاظ المنثالة، مستشهداً بكتابات الجاحظ في هذا المجال.
هذه هي الأعمال الأدبية التي اعتبرها صادق جلال العظم تستحق التقدير الفني والنقدي، وهي المرتبطة بالتخييل والفانتازيا لمعالجة موضوعات الواقع، المرتبطة بأدب الالتزام، وأدب القضايا السياسية والاجتماعية، وأدب معارضة المقدس وتعريته، والأهم، دفاعه عن حق الروائي في استعمال التقنيات الأدبية التخييلية والفنية في حدودها القصوى.
——————————–
رصيف 22
========================