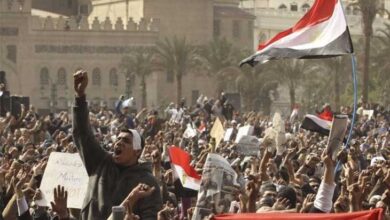في فلسفة اللغة… اللغة والعقل والتسلّط/ ماهر مسعود

في كتابه “تكوين العقل العربي“، يخلص محمد عابد الجابري إلى نتيجة بحثية إشكالية، وهي أن اللغة العربية هي لغة “حسيّة ولا تاريخية”، وأن “الأعرابي هو صانع العالم العربي”، فحسيّة اللغة جاءت من حقيقة أن صانعي القواميس العربية، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلامذته، عادوا إلى القبائل البدوية المعزولة في الصحراء، وإلى الأعراب “الأقحاح” الذين لم يتعكر صفو لسانهم بالاختلاط مع سكان المدن والحضر، ليحققوا الألفاظ والمعاني والكلمات، وليبتعدوا عن “اللحن” الدخيل والكلمات الغريبة والأعجمية، تلك التي بدأت تدخل على اللغة وتتداخل معها نتيجة فتوحات وانفتاح الحضارة العربية على الحضارات المجاورة واللغات الأخرى. ولذلك فإن الثمانين ألف مادة لغوية التي يحتويها قاموس “لسان العرب” الضخم، على سبيل المثال، لم تخرج عن حياة ذلك الأعرابي الذي كان بطل عصر التدوين[1]. بينما جاءت “لاتاريخية” العربية من إخضاع محتواها اللغوي إلى المنطق الصوري ونظام التقاليب الستّة، الذي يعني تقليب الممكنات النظرية للمصادر الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية للكلمات (مثلًا كلمة حرب، بحر، رحب، حبر، ربح.. الخ) لعزل الكلمات التي تحمل معنى عن غيرها، وإدراجها في بنية اللغة، وهو ما أدى -بحسب الجابري ومصادره- إلى استخراج 12 مليون و305412 لفظًا، وإلى أن تصبح الكلمات صحيحة، لأنها ممكنة لا لأنها واقعية، وبالتالي باتت اللغة محصورة ضمن قوالب منطقية جامدة، متعالية على التاريخ أو “لاتاريخية”، لا تتجدد بتجدد الأحوال، ولا تتطور بتطور العصور[2].
بالنسبة للجابري، فإن جمود اللغة العربية لم يقابله طبعًا جمود الحياة الاجتماعية، لا في عصر التدوين ولا اليوم، بل إن الحياة الاجتماعية انتقمت لنفسها بفرض لهجات “عربية” عامية، كانت وما تزال “أغنى” كثيرًا من اللغة الفصحى. وهو ما فرض -برأيه- تمزقًا رهيبًا ما زال يعانيه الإنسان العربي إلى اليوم، ذلك أنه من جهة يتوفر على “لغة للكتابة والتفكير على درجة عالية من الرقي، من حيث آلياتها الداخلية، لكنها لا تسعفه بالكلمات الضرورية عندما يريد التعبير عن أشياء العالم المعاصر”، وهو ما يصل إلى درجة “أننا لو قررنا عدم النطق إلا بالألفاظ العربية التي تعترف بها قواميسنا، لكان علينا أن نمسك عن الكلام معظم الوقت في منازلنا وشوارعنا ومدارسنا”. وعلى الرغم من غنى العامية “التكنولوجي” والحضاري، فهي ليست لغة ثقافة وفكر، ومن هنا كان مصدر فقرها المدقع، على الرغم من غناها الظاهري، وتلك المفارقة توجب على المثقف العربي العيش في عالمين كلاهما قاصر: عالم لغته العامية، وعالم اللغة الفصحى[3].
إذا تركنا جانبًا نتائج الجابري؛ التي قد يتفق أو يختلف معها كثيرون، وانتقلنا إلى التفكير الفلسفي في ماهية اللغة، فسنجد أنه في حال كانت اللغة هي مجرد أداة للتواصل والتعبير والتفكير، وكانت مجرد تواضع واتفاق بين الناس في مجتمع ما؛ كما يردد العديد من المفكرين القدامى والمعاصرين، فإن ذلك يحيلنا إلى أن الكلمات التي تحتويها أي لغة لا تشير إلى معان أصيلة أو ماهيات ثابتة موجود في الواقع، لأنها كلمات موضوعة وضعًا ومتفّق عليها اتفاقًا، بكلام آخر: إن العلاقة بين الكلمة وما تشير إليه (مثل كلمة بيت، والبيت الموجود في الواقع) هي علاقة عشوائية بالمطلق، ولا تتشكل علاقة الكلمة بمعناها (الدال والمدلول) إلا نتيجة اتفاق الناس عليها ووضعها في بنية لغوية. ومن المعروف أن تلك النتيجة البسيطة كانت بداية ثورة في علوم اللغة “السيميولوجيا” بدأها فريدناند دوسوسير، ولم تلبث أن انتقلت إلى الفلسفة والعلوم الأخرى بداية القرن العشرين، وسأشرح معنى تلك الثورة.
قبل دوسوسير كان السائد هو أن الأفكار هي انعكاس للواقع، وبقدر ما تتطابق الأفكار مع الواقع وتعبّر عنه، تكون صحيحة، وهو ما رفع من أهمية الذات المفكرة، “أنا أفكر إذًا أنا موجود” (ديكارت). لكن بعد الثورة اللغوية اتضح أن الإنسان لا يفكر إلا ضمن بنية لغوية وثقافية معينة، ولا معنى لكلماته وأفكاره؛ وبالتالي له هو ذاته، خارج تلك البنية التي تحدده وتحدد أفكاره وعلاقته بالعالم، فاللغة هي أداة للإنسان، لكنها الأداة التي تصنعه أيضًا. وتلك البنية اللغوية ليست انعكاسًا لأشياء العالم الخارجي، بل إن كلماتها لا ترتبط إلا اتفاقًا بالأشياء التي تعبر عنها. وقد كان لهذه التحديدات معان كبيرة وكثيرة منها مثلًا:
– كسر قداسة الكلمات، فالكتب المقدسة لم تخلق كلماتها من العدم، ولا من أي كائن متعالٍ، ولم تُنزّل تنزيلًا، بل هي خُلقت وكُتبت اتفاقًا وتواضعًا بين الناس للتعبير عن حاجات بشرية ضمن بنية ثقافية اجتماعية معينة في وقت معين.
– كسر قداسة الإنسان والذات الإنسانية المفكرة، فليس هناك إرادة حرة تخلق شروطها وتبدع نصوصها وأفكارها من شخصياتها الفذّة؛ كما يخلق الله العالم، بل إن الذات محكومة بحدود اللغة، وبالبنية الاجتماعية الثقافية التاريخية التي تنشأ فيها، ويتحدد نشاطها وأفكارها وتصوراتها و”إبداعاتها” بحدود تلك البنية.
– مثلما تتحدد أفكارك ضمن بنية اللغة التي تفكر من خلالها وبنية الثقافة التي تعيش فها، كذلك أيضًا ذوقك في الموسيقى، في المأكل والمشرب، في اللباس، الأفكار الدينية التي تؤمن بها، العلم الذي تتبعه، الأخلاق، الجريمة، الحب، الاقتصاد.. الخ، جميعها لا معنى لها خارج البنى التي تحددها، وجميعها بلا أصالة ولا جوهرية ولا هي تمثيل للحقيقة والمثال، ولا تفاضل في المحصلة بين البُنى المحددة للثقافات والمجتمعات المختلفة على الاطلاق.
– كسر قداسة التاريخ، فالتاريخ لا يصنعه القادة والزعماء والأباطرة، بل إن تلك الذوات تصنعها البنى التي وجدت فيها. ومن تلك المنطلقات الجديدة تمت إعادة قراءة ماركس وفرويد بنيويًا، والاستعانة بشروحاتهما على الطريقة البنيوية، فالبنية التحتية عند ماركس (أي الاقتصاد) هي ما يحكم الطبقة التي أنت فيها، وكذلك اللوحة التي تحبها، والأخلاق والدين والسياسة السائدة في المجتمع. والبنية اللاشعورية عند فرويد، هي ما يحكم سلوكك الاجتماعي، وأمراضك النفسية، وميولك واتجاهاتك الثقافية، والطابع الأوديبي لعائلتك هو ما يحدد توجهاتك السياسية وعلاقتك بالآخرين تبعًا لعلاقتك بوالديك.
بعد كل تلك النقلات التي حدثت نتيجة الاختراق الذي بدأ في علوم اللغة، انتقلت مشكلة اللغة من السيمولوجيا إلى الأيديولوجيا، وباتت جميع أفكارنا هي عبارة عن أيديولوجيات تخدم سلطات معينة، دينية أو سياسية أو كلاهما معًا، فمثلًا بيّن كلود ليفي شتراوس كيف أن الأديان هي مجرد أساطير حولت التاريخ إلى حقيقة والقصص إلى حقائق، وأن الأسطورة ذاتها ليست إلا “حقيقة” زمن معين، وهذا معناه أنه لا فرق بين أساطيرنا “حقائقنا” في القرن الحادي والعشرين وأساطير الأولين. ثم بيّن فلاسفة ما بعد الحداثة، من أمثال جاك ديريدا وميشيل فوكو وجيل دولوز، كيف أن تعامل فلاسفة الأنوار مع العقل والحقيقة والتاريخ لا يشبه إلا تعامل القرون الوسطى مع الله كجوهر أصلي يعلو فوق الزمان والمكان، وكيف أن اللغة تحدد الخطاب السياسي والكلمات المستخدمة في الحقل السياسي، بالطريقة ذاتها التي تحدد بها السياسة والقائمين على السلطة ما يمكن أن يُقال أو لا يقال في زمن معين، وفي المحصلة؛ فإن كل ما سبق، لا بد من إعادة تفكيكه لإبراز الكامن بين سطوره والمخفي في أحشائه والسُلَط الكامنة خلفه.
الآن، بالعودة إلى اللغة العربية، التي رسمت حدود الثقافة العربية، وصاغت ممكنات التفكير والتعبير لدى الإنسان العربي، سنجد أن هناك حدين متباعدين على قدر ما هما متقاربين، ينوس بينهما الفكر العربي عندما يعبّر عن نفسه.
الحد الأول هو الأصل القابع في الماضي؛ رأيناه مع الجابري بالعودة للبدوي والتعلم منه، ونراه اليوم في كيفية قياس الحديث على القديم والكلمات الجديدة على الأصول القابعة في القواميس، ومن تلك الآلية نرى أيضًا مدى تأثير فكرة الأصالة والعمق التاريخي في إنتاج وإعادة إنتاج سلطة الدولة أو العشيرة أو الطائفة أو الشعب، وكيف تجتهد وتتسابق السلالات الحاكمة لرد أنسابها إلى أصقاع الماضي ورموزه، لتمنح نفسها شرعية في الحاضر. إذًا ما بدأ في حقل اللغة انتقل إلى الحقل الاجتماعي والسياسي وبات يلعب دورًا في نظرة الإنسان لنفسه وأخذ قيمته الحالية من أصله القديم والغارق في القدم.
والحد الثاني، الذي يبدو مناقضًا للأول ومكملًا له في الوقت ذاته، لا يعود إلى الماضي بل يبدو متعلقًا بالمتعالي، المثالي والكامل، رأينا ذلك مع الجابري في تبيانه لنظام التقاليب الستة عند الفراهيدي، وهو الباحث عن مثالية اللغة والكلمات في ذاتها بمعزل عن الواقع، والذي يجعل الإمكان الذهني هو المقياس الذي يُستخلص منه الوجود الواقعي. ونراه اليوم في المحاولات الدائمة لأصحاب ما يسمى “الإعجاز العلمي في القرآن”، حيث يبدو الكتاب المقدّس، الكامل والمثالي، حاملًا لإمكانية لا نهائية في ذاته لتفسير الوقائع الجديدة، سواء تعلقت بالذرة أو بالفضاء، بالكبائر أو الصغائر. ونراه أيضًا في التراتبية الاجتماعية والسياسية المرتبطة باللغة، حيث يبدو المتحدث باللغة الفصحى وكأنه من طبقة أعلى، وتعطي بلاغة الحديث أهمية للمتحدث، بالرغم من سخافة الحديث نفسه أحيانًا، بينما تُحيل العامية إلى الجهل والشعبوية وقلة القيمة، بغض النظر عن أهمية ما يُقال. تلك التراتبية التي تجد أساسها في اللغة، وتقسم عالم الإنسان العربي إلى عالمين، تمنح أيضًا شعورًا وهميًا بالتفوق وامتلاك السلطة والتعالي، وتؤسس للاستبداد السياسي والاجتماعي الآنتي ديمقراطي؛ حيث إن التقديس الذي يبدأ بالكلمات يتحول إلى آلية نفسية ونظرة للعالم، وينتهي بتقديس الذات، والذات المقدسة -سواء كانت لمستبد أو لرجل دين أو لمفكر أو مثقف ورجل علم- لا يمكن نقدها دون المساس بتعاليها، ولا يمكن تصويبها لأنها مالكة للحقيقة. ومن هنا نرى أن كثيرًا من المثقفين والمفكرين مثلًا، بغض النظر عن إيمانهم أو إلحادهم، يتعاملون مع نصوصهم وكأنها مقدسات، ومع كتاباتهم وكأنها مُنزلة، ومع “إبداعاتهم” وكأنها خلق من عدم. وهذا ما يسهّل في المحصلة أن تتحول الخلافات بالرأي إلى خلافات شخصية، ويفسر ظاهرة الشللية والأتباع، لكن في حالات أخرى رأينا كثيرًا في تاريخنا كيف انتهى النقد واختلاف الرأي بقتل الناقد والمختلف، سواء من قبل الإسلاميين أو المستبدين.
إن أولئك الذين ما زالوا يتغنّون بجمال اللغة العربية وكأنها عذراء جميلة، ما زالوا يظنون فعلًا أن كل عذراء هي حتمًا جميلة، وأن نقد الجميل هو حتمًا تحطيم للجمال. وأولئك الذين يظنون أن أبحاث اللغة متعلقة باللغة وحدها، ويقوم بها مختصون وتقنيون ورعاة نحو وصرف وقواعد، لا يدركون أن اللغة هي عقل تصنعه ليصنعك، وهي أداة تحكمها لتعاود حكمك.
[1]– الجابري، محمد عابد، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط10، 2009، ص86.
[2]– المرجع ذاته، ص82
[3] -انظر الجابري، المرجع نفسه، ص79-80
مركز حرمون