هل يتمكّن الفنّ من مُناهَضة التّفاهة في سورية؟/ أحمد عزيز الحسين

يرى الفيلسوف الكنديّ ألان دونو في كتابه “نظام التّفاهة” أنّنا نمرُّ بمرحلة تاريخيّة يسيطر فيها التّافهون على محاور الدّولة الحديثة كلَّها، وأنَّ مؤسَّسات هذه الدّولة تسعى إلى تحقيق أهداف هذه الشّريحة من خلال وضع الاستراتيجيّات والخطط والآليّات التي تضمن تجذير نظام التّفاهة في الفضاء الاجتماعيّ العالميّ، وترسيخ قيمه الرّمزيّة، ومثله الجماليّة.
وتُعَدُّ المؤسَّسات الخاصَّة أحدَ أذرع الدّولة الحديثة في استِنْبات الظُّروف التي تضمن لـ”نظام التّفاهة” تشكيل السِّياق الذي يساعدها على تحقيق أهدافها، إذ تقوم شراكَةٌ غير معلنَة بين المؤسَّسات الحكوميّة والخاصّة بغية خلق الظّروف الموضوعيّة التي تسمح لكليهما بالهيمنة والاستمرار؛ وفي مقدِّمة ذلك تنشئةُ جيل شابّ يعتمد على الحفظ والتّلقين ألان دونو
في بناء وعيه العلميّ بغية إقصاء قدرته على المحاكَمة، والتّفكير النّقديّ الخلّاق، والاعتماد على النّقل لا العقل، ممّا يُفضِي إلى غياب قدرته على المساءلة، وإماتة شغفه إلى البحث والإبداع، وجعله نسخةً طبق الأصل من روبوت تكنولوجيّ لا يُحسّ ولا يشعر، ولا يعمل على تطوير ذاته، أو الاقتداء بالآخر، والتّفوُّق عليه، بل ينفِّذ ما يُملَى عليه، وما يُطالَب به وحسب، ويغدو الهوسُ الماليُّ، والحصولُ على الثّروة، هما الهدفَ الرّئيس للمهيمِنين على مفاصل الدّولة المذكورة، بحيث تتراجع القيمُ الجماليّة والمُثُل الجماليّة العليا عن صدارة السّاحة الفكريّة والشّعوريّة للإنسان في هذه البلدان، وتتقدّم بدلًا منها قيمُ التّسفُّل، والاستهلاك، والرِّبح السّريع.
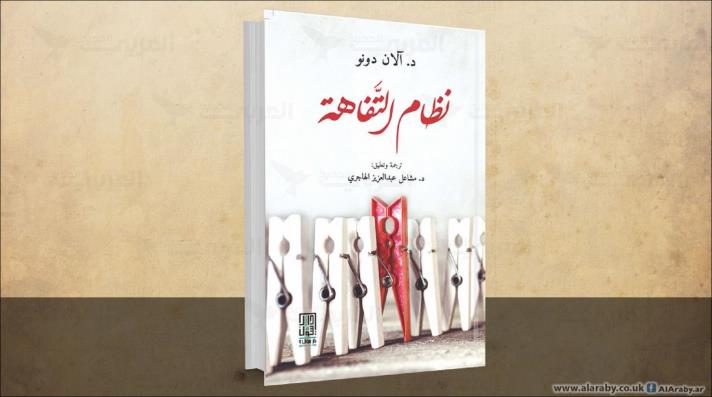
وفي ظنّي، أنّ الدّولة الحديثة، على اختلاف مُسمَّياتها وأنماطها، تسلك السّبيل نفسه في هيمنتها على مواطنيها، وإعادة تشكيلِهم وقَولَبَتِهم، وليس هنالك سوى فروقٍ طفيفةٍ بين دولة وأخرى في طبيعة هذه الهيمنة، ففي فرنسا على سبيل المثال “تُعَـدُّ الأقنيةُ المتعدِّدة للتّلفزيون الفرنسيّ حِكْرًا على مجموعات معيَّنة تفتح الباب على مصراعيه لكلّ هابط من الفنون الغنائيّة التي تفضِّل (العرير) على الغناء الرّاقي والأصيل، كما تقدِّم المسلسلات البوليسيّة، أو المضحِكة، التي يكون المُتَهَّم فيها في الغالب ذا بشرة داكنة، أو من بلد (إرهابيّ !!)”، كما يقول الدكتور ولي الدين السّعيديّ، المحاضر في الجامعات والمعاهد الفرنسيّة، أمّا القنوات التي تحرص على بثّ موسيقى راقية فهي نادرة للأسف، ويرى الدّكتور السّعيديّ أنّ هذا الهبوط مُتقصَّد، وتخطِّط هذه القنوات للوصول إليه بذكاء، ويدفع القائمون عليها لقاء ذلك مبالغ طائلة يحصلون عليها من الشّركات متعدِّدة الجنسيّات، وهي الشّركات المهيمِنة على رأس المال الثّابت والسّائل في العالم كلّه.
وفي حين تُبقِي الدُّول الرّأسماليّة المجال مفتوحًا للأثرياء الجدد والرّأسماليّين الكبار كي يُراكِموا (المال) في حساباتهم المصرفيّة من دون حدود، فإنّها تكاد لا تمنح الفقراءَ الفرصةَ كي يحصلوا على لقمة عيشهم من دون أن تجعلهم يعيشون الإذلالَ نفسَه الذي يتعرّض له فقراءُ العالم الثّالث، مع أنّ هذه اللُّقمة تُسرَق في الغالب من أفواه الفقراء والجياع في هذه البلدان، وتُوضَع في أفواه مواطنيها من دون وجه حقّ، وبالتّعاون مع الحكومات الاستبداديّة في هذه البلدان.
أمّا الدُّول الكولونياليّة التي تدور في فلك التّبعيّة للدّول الرّأسماليّة العالميّة، فإنّها ترضى في الغالب بدور المسوّق لنظام التّفاهة والاستهلاك وقيمه الرّمزيّة؛ وتفتح له أسواقها الوطنيّة، وتُتِيح له استخدام مؤسَّساتها الثّقافية والتّربويّة والإعلاميّة بغية نشر مفاهيمه الفكريّة، وترويج منتوجاته المختلفة، كما تساعده على تحويل أبنائها إلى عجينة طيّعة بين يديه، بحيث يغدو مثلُهم الأعلى هو العيشَ وفق الآليّة التي ينتهجها مواطنو الدُّول المذكورة، حتّى لو لم يكونوا يملكون القدرة على ذلك. وقد وصل الحال ببعض مواطني الشّريحة المتوسطّة في لبنان وسورية إلى حدّ استلاف قروض طويلة الأجل من البنوك الخاصّة بقصد إجراء عمليّات تجميليّة لتغيير معالم أجسادهم بغية قبولهم في نظام الاستهلاك العالميّ، وإيجاد موطئ قدم لهم في مؤسّساته المختلفة، مع أنّ النّتيجة مُحبِطة في الغالب، وأفضتْ إلى إحداث تشويهات كارثيّة طالتْ بنى هذه الأجساد، ولم تُفضِ إلى النّتيجة الجماليّة المرجوَّة التي كان معظمُ هؤلاء يطمحون إليها، وفي مقدّمتهم فنّانو هاتين الدّولتين، ممّن يملكون إمكانات مادّيّة كبيرة تسهِّل لهم إجراء هذه العمليّات.

وقد يكون تسفيلُ الفنّ، وتقزيمُ دوره، وحرفُه عن مساره الحقيقيّ هو ما يسعى نظام التّفاهة إلى إشاعته في الفضاء الاجتماعيّ للدّول التي تتبنّى مفاهيمه، بغية تحقيق أهدافه على المدى البعيد، ولا يمكن أن يتمّ ذلك إلا إذا أقصِي المثقفّون والفنّانون الأصلاء عن القيام بمهمّاتهم في الارتقاء بوعي النّاس، وصقْل خبراتهم الجماليّة والسّمعية والبصريّة؛ وإحلال الفنّ المزيَّف محلّ الفنّ الأصيل بغية تكوين مواطن شائه وضعيف من السّهل التّحكُّمُ به، وتوجيهُه لانتهاج المسار الذي يطمح هذا النّظامُ إلى موضعته في أرض الواقع.
وإذا أخذنا سوريّة مثالًا لما تساوق مع نظام التّفاهة والاستهلاك العالميّ الذي أخذ يزحف بلا هوادة إلى حياتنا، ويدمِّر أنماط الحياة المستقرّة فيها، ويعمل على تشكيل نمط حياة آخر يتضافر معه في التّرويج لمفاهيم جديدة لا تتناسب مع إمكاناتنا الاقتصاديّة، وتتلاءم مع أسلوب حياة مغاير باتت تتلهّف للحصول عليه شريحةٌ جديدةٌ طفَتْ على سطح الحياة الاجتماعيّة، وساعد على ظهورها وتسيُّدها في فضائنا الاجتماعيِّ عواملُ غير اقتصادية، يسمِّيها علماء الاقتصاد بـ”اقتصاد الظلّ”، فسوف نلاحَظُ أنّ ملكة التّذوّق الفنّيّ للموسيقى، والفنون التّشكيليّة، والغناء التّراثيّ الأصيل، والأفلام السّينمائيّة، والعروض المسرحيّة، قد تردّتْ بالتّناظر مع ما طفا على سطح الحياة الاجتماعيّة السُّوريّة من قيم ومثل جمالية متسفِّلة، وتوازى ذلك مع انصرافِ النّاس إلى مشاهدة الغناء الهابط، والمسلسلات التّلفزيونيّة الغثّة، أو التي تمحورت حول الموضوعات التّاريخيّة (المُختَلَقَة)، أو التي غرقَتْ في حكايا الماضي القريب، وأدارَتْ ظهرَها إلى القضايا المصيريّة الملحّة للمواطن السّوريّ، وإنْ وُجِدتْ مسلسلاتٌ تتصدّى لقضايا كهذه فهدفُها إيصالُ هذا المواطن إلى الدّرجة التي تمكّنُهُ من تفريغ الشُّحنة الانفعاليّة التي يحملها في صدره، من دون أن يترافق ذلك مع وعيه لواقعه، والقدرة على تكوين حكم قيمة جماليّ عليه، وإنْ كان المرءُ لا يعدم وجود أعمال فنيّة لعبتْ دورًا مهمًّا في صياغة الوعي الاجتماعيّ، وإعادة تشكيله كـ”مسرح الشّوك”، و”مرايا ياسر العظمة”، و”ضيعة ضايعة”، و”بقعة ضوء” و”ببساطة”، وغيرها، وقد كوّنت هذه الأعمال فسحةً جمالية وبصريّة أطلّ الكاتبُ، أو المخرج، أو الفنّان السّوريّ، من خلالها، على الجمهور عاكسًا رؤيته لهموم النّاس والمُعوِّقات التي تواجههم في حياتهم اليوميّة، وقد تنامى هذا الدّور طردًا مع تنامي نظام التّفاهة، وهيمنة قِيَم عصر الاستهلاك والتّسطيح على فضاء الحياة السّوريّة والعربيّة معًا، وتراجُع وسائل التّعبير الأخرى كالمسرح، والسِّينما، والكتاب، والصّحافة الثّقافيّة، عن التّأثير في هذا الفضاء؛ بحيث باتت الشّاشة الصّغيرة أحد أكثر العوامل الفاعلة والمؤثِّرة في تشكيل وعي النّاس، وصياغة رُؤاهُم لذواتهم والواقع الذي يعيشون فيه، كما أصبحت المسلسلات التّلفزيونيّة الوسيلة الأهمّ التي يحتكمون إليها في صياغة نمط حياتهم، وتشكيل رؤيتهم لواقعهم لكونها تقدِّم الفكرة التي تودّ إيصالها للمتلقّي بشكل مخاتِلٍ وشائق، أو بقالب كوميديّ، أو تراجيديّ، تقوم بتشكيله عناصرُ ومؤثِّراتٌ متعدِّدة كـ (الصّورة، والموسيقى التّصويريّة، والإضاءة، والدّيكور، والماكياج)، وغيرها، وقد ازداد هذا الدّورُ قوّةً وتأثيرًا وخطورةً في ظلّ تغييب المنابر الثّقافيّة والنّقديّة الرّسميّة التي يمكن أن تساهم في معالجة القضايا التي تطرحها الدّراما، أو تُنبّه إلى مكامن الخلل والتّشويه التي يمكن أن يبثّها المخرجُ، أو الكاتب عبر ما يشكِّله من نصٍّ بصريّ ممتع، والّذي قد يكون عفويًّا حينًا، أو متعمَّدًا في أغلب الأحيان. وقد ازدادت هذه المسلسلات أهميّةً مع اعتمادها الكوميديا، أو الدّراما الجادةّ، أداة ً بصريّة ونهجًا فنيًّا في مخاطبة المتلقّي، ولا سيّما أنّها وفرّت له عنصر المتعة والتّشويق، وجعلتْه يتابع ما يراه برغبة عارمة بغية اتّخاذ موقفٍ واعٍ (أو مزيَّف) ممّا يحيط به.
ولا شكّ في أنّ ارتقاء الذّوق الفنّيّ للمواطن العربيّ عمومًا، والسّوريّ خصوصًا، لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تدريبه باستمرار على مشاهدة الأعمال الفنّيّة الرّاقية، أو الاستماع إليها، ومناقشتها مناقشة عميقة لمساعدته على صقْلِ ذائقته الفنّيّة وخبرته البصريّة والسّمعيّة معًا، وهذا لا يتمّ إلا من خلال توافر البيئة الثّقافيّة والفنّيّة الحاضنة، والبنية التّحتية المتطوّرة التي تضمن له الحصول على المتعة الرُّوحية السّامية التي يمكن أن ترتقي بوعيه الجماليّ باستمرار.
وفي ظلّ الظُّروف القاهرة التي يعيشها المواطنُ السُّوريّ، والتي ينشغل فيها بتوفير الاحتياجات الأساسيّة لأسرته، بات من النّافل أنْ تطلبَ من هذا المواطن اصطحابَ أسرته لمشاهدة فيلم سينمائيّ، أو عرض مسرحيّ، أو الاستماع إلى فرقة تراثيّة، أو أوبراليّة، تعزف مقطوعات كلاسيكيّة، أو منتخبَة من تراث عصر النّهضة المستنير، هذا إنْ توافرتْ هذه الفرقةُ أصلًا؛ مع أنّ “بعض المحافظات السُّوريّة كانت قبيل الحرب تنعم بمثل هذا الزّاد الرُّوحيّ، وكان بعض مثقفِّيها الجادّين يحرصون على توفيره بما يملكون من إمكاناتٍ متواضعة، ورغبة عارمة في التّطوير والتّنوير”، كما يقول الصّحافي ّ نضال بشارة (حمص)، وقد انكفأ أغلبُ هؤلاء على أنفسهم، أو هُجِّروا، أو رحلوا عن الحياة الدّنيا بعد أن تركوا فراغًا روحيًّا من الصّعوبة سدُّه، ومع أنّ هنالك جنودًا مجهولين لايزالون يصارعون في سبيل بعث فنٍّ سامٍ وخبرة جماليّة راقية في كثير من المحافظات السّورية كدمشق، وحلب، وحمص، واللاذقيّة، وطرطوس(1)، إلّا أنّ مواجهة التّفاهة، كما يقول الباحث الجماليّ سعد الدين كليب (جامعة حلب)، “لا يمكن أن تتمّ من خلال مبادرات فرديّة، أو خاصّة”، أو “من خلال أنشطة متقطِّعة تقوم بها هذه المؤسَّسة، أو تلك”، فتيّارُ التّفاهة الجارف “أخطرُ وأعمق من أن تتمّ مواجهته بمثل هذه الأنشطة، حتّى لو كان مستواها رفيعًا”، كما يقول كليب.
كما أنّ “الجزر الصّغيرة التي تبحث عن ذاتها، وعن هُويّة وطنيّة متقدِّمة، عاجزة عن إحداث فرق”، كما يؤكّد الباحث أحمد غانم (طرطوس)، ذلك أنّ ظروف الحرب أحدثت في حياة الجيل الجديد شرخًا نفسيًّا تجلّى بنزعات عدميّة واستهتار بكلّ القيم، وهو جيل منفصل عن سابقيه بشكل تامّ، وقد أمست التّفاهة ميدانه الأرحب وهواه ومطلبه، وأصبحتْ محاولة إنقاذه ممّا هو فيه وصرفه عمّا يمتّعه، في أمسّ الحاجة إلى خطط واستراتيجيّات علميّة، وإلى كوادر وطنيّة مؤهَّلة وواعية، كما أنّ هذا الجيل لم يعد يهتمّ بتراثه الفنّيّ العاجز عن مواكبة العصر؛ فالطّرب الحلبيّ بقي كما هو، ولا يزال يراوح عند القدود والموشَّحات والمواويل، وهي ألوان من الغناء لم تعد تلبّي حاجة الجيل الجديد إلى ما يرغب في سماعه في ظل حمّى الاستهلاك والغناء الوضيع اللّذين اجتاحَا الفضاء الفنّيّ السّوريّ، فضلًا عن أنّ أغلب مقدِّمي هذه الأنشطة وروّادها أمسَوْا من كبار السِّنّ، وهؤلاء لا يزالون يعيشون في الماضي، ويحرصون على تقديم أدبٍ وفنٍّ لا يتماشيان مع التّغيُّرات الهائلة التي اجتاحت المدن السُّوريّة في فترة ما بعد الحرب، كما أنّ المناخ العامّ في أغلب هذه المدن بات محكومًا هو الآخر بالتّفاهة والاستسهال والجري وراء القشور والمظهر المخادع، وأمست هذه الأنشطة تجري بهدف التّأكيد على أنّ كلّ شيء عاد إلى ما كان عليه قبل الحرب، مع أنّ بنية المجتمع السّوريّ تصدعّت، وتغيّر كلُّ شيء فيها، وما عاد من الممكن أن تخاطب المواطن نفسه بالآليّة نفسها التي كنتَ تخاطبه بها قبل ذلك، ولا أن تضحك منه، وتوهمه بأنّ كلّ شيء بخير، أو أن تغنّي له أغنية عن واقع رومانسيّ وامرأة متخيّلة يرضيها باقة ورد؛ أو أن تسرد له قصة مختلقة لا علاقة لها بواقعه؛ فقد تغيّرت صورة الحبيبة وصورة الواقع المتخيَّل بالتّوازي مع ما جرى في بنية الواقع الموضوعيّ، كما تغيّر مفهوم الحبِّ نفسه، وأمستْ إقامةُ علاقة عاطفيّة بين حبيبَيْن محكومةً بما حدث، ومتأثِّرة به، كما تغيّر المزاجُ العامّ، والتّذوُّق الفنّيّ، تغيُّرًا جذريًّا، وأمست الحياة الثّقافيّة والفنّيّة السُّوريّة تعيش في ظلّ جدب وقحط روحيّ لا مثيل لهما، كما تراجع دور الجامعة عمّا كان عليه الحال في عقدي السّبعينيّات وأوائل الثّمانينيّات، إذ كفّتْ، أو كادتْ، عن القيام بالمهرجانات الثّقافيّة والنّدوات والأمسيات واللِّقاءات الفكريّة والأدبيّة التي كانت تقيمها في رحاب مدرَّجاتها وخارجها معًا، أو استمرّت في القيام ببعضها من دون أن يقبل عليها الجمهور المنشود. ويعزو بعض الباحثين ذلك إلى أنّ معظم هذه الأنشطة تنأى بنفسها عن هموم النّاس، وتنصرف خائفة عن مقاربة الثّالوث المحرّم، وما طال مفاهيمه من تغيُّر في ظل التّغيّرات العاصفة التي أصابت الفضاء الثّقافيّ العربيّ والسّوريّ معًا. وقد أحدث هذا كلّه فجوة بين الجيل الجديد والمؤسَّسات التي تنهض بالأنشطة الثّقافيّة، أو الفنّيّة، سواء كانت عامّة، أم خاصّة، فانصرف عنها غير مكترث بها، ولا معترف بوجودها بعد أن أمست مجرَّد هياكل منبتّة عن حياته. وقد عبّر الأديب عبد الحميد يونس (طرطوس) عن رأيه بما تقوم هذه المؤّسسات من أنشطة، وموقف النّاس منها، فكتب منشورًا ساخرًا يقول فيه بالحرف الواحد:
“آخر مرّة حضرْتُ فيها أمسية أدبيّة لم أفاجَأ بامتلاء مقاعد المدرّج عن بكرة أبيه، بل فوجِئْتُ بأنّ أكثر من نصف الحضور الذوّاق كان يراجِع من شدّة الإعجاب والدّهشة الجماليّة، لدرجة أنّ أصوات (الزّولعة) كادت تطغى على النّشيد والتّغريد…
يا ناس.. يا عالم.. يا سامعين الصّوت! أوقِفوا هذا الزّحف المجنون إلى صالات المراكز الثّقافيّة، وصالات فروع اتحاد الكتّاب، أو على الأقلّ خصّصوا دوريّات مدرّبة لحماية مبدِعينا من هجمات المعجَبات والمعجَبين الفجائيّة في أمسياتكم وظهريّاتكم وأصبوحاتكم الثّقافيّة، فقد كادت الجماهير تتعطّل عن أعمالها، وتترك أرزاقها لمجرّد أن تسمع بأمسية.
أبوسْ سماكُمْ.. ارحمُوا سمَانا…”.
هامش:
(1) لا بد أن نذكر هنا بعض هؤلاء الجنود: بِشْر عيسى، وهو موسيقار وباحث في فلسفة الفنّ والموسيقى/ طرطوس، وشادي أحمد، وهو باحث ومؤرشِف للتّراث الموسيقيّ السّوريّ/ طرطوس، ورامي درويش، الموسيقار والباحث والعازف والأستاذ في جامعة البعث في حمص، وعبد الباسط بكّار، رئيس فرقة العاديّات للموسيقى التّراثية/ حلب، وعبد الحليم الحريري، رئيس نقابة الفنّانين في حلب، وزاهد بيرقدار، وكامل قبّاني، عضوا فرقة العاديات للموسيقى التّراثيّة في حلب، والمطربان عمر سرميني، وعبّود شعبان (حلب)، وعازف الكمان زياد زيتونيّ/ حلب، ومن الفنّانين المخضرمين الذين لا يزالون يثرون حياتنا بعطائهم وحضورهم الفنيّ والبحثيّ البازغ ينبغي أن نذكر نزيه عبد الحميد من طرطوس أيضًا.
ضفة ثالثة




