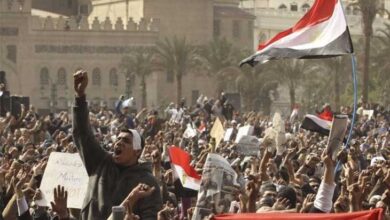الفلسفة وعصر العلم/ ماهر مسعود

ليس التساؤل حول نهاية دور الفلسفة أمام التقدم العلمي جديدا، بل كان السؤال المركزي لعشرينيات القرن الماضي في الغرب، وقد حدث ذلك نتيجة القفزة العلمية الهائلة التي شهدتها العلوم التطبيقية في شتى الميادين، من الطب إلى الفيزياء، ومن الصناعات العسكرية إلى التحليل النفسي إلى علوم اللغة. وقد جاء التشكيك في الفلسفة من داخل الفلسفة ذاتها، ولاسيما مع مدرستي التحليل اللغوي والوضعية المنطقية اللتين أرادتا تحويل الفلسفة إلى علم.
جعل فتجينشتاين مثلاً الفلسفة مجرّد تحليل لغوي لمعرفة الكلام العلمي الذي يحمل معنى، وتمييزه عن الكلام غير العلمي، الذي لا معنى له. وأعلن في «التراكتاتوس» أن كل كلام لا يمكن إيصاله إلى الآخر بصورة واضحة، ولا يمكن التحقق من صدقه أو كذبه، هو كلام بلا معنى، وبذلك أصبح السؤال الفلسفي عن معنى الحياة عنده، سؤالا بلا معنى.
قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف القرن، كان كانط قد حدد علاقة الفلسفة بالعلم ضمن مقولته الشهيرة: «إن الفلسفة بلا علم جوفاء، والعلم بلا فلسفة أعمى». وهي مقولة ما زالت تحمل شيئا من الصِحّة، إلا أنها تعمي الأبصار عن معنى العلم ذاته. فالعلم بصورته المعاصرة لم يعد يمثل الحيادية المفصولة بالكامل عن الرغبات، والموضوعية المنفصلة بالكامل عن الذات، والنزاهة المجردة عن الغايات. بكلام آخر، لم يعد العلم تعبيراً عن الحقيقة بألف ولام التعريف، لا في الفيزياء ولا في أي فرع من فروع المعرفة، بل إن الأمر يصبح أعقد وأكثر إشكالية عند الدخول في علوم الإنسان والتاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة، حيث تصبح الذات البشرية هي موضوع الدراسة وذاتها في آن واحد.
في علوم الطبيعة، أدخل نيتشه فلسفياً مفهوم المنظور perspective إلى حيّز المعرفة نهاية القرن التاسع عشر، وبالتوازي؛ أو بشكل منفصل، أدخل فيرنر هايزينبرغ هذا المفهوم إلى العلم مع بداية القرن العشرين، وطبّقه في مجال الفيزياء الذرية وميكانيكا الكم، لكي يصيغه في مبدأ عدم اليقين، فعندما تنظر إلى الإلكترون من جهة موقعه، لا يمكنك قياس سرعته، وعندما تراه من منظور سرعته تفقد موقعه. ثم عاد هذا الكلام إلى الفلسفة لمعالجة إشكالية تحديد الواقع (ما الواقع وما هو الواقعي؟) حيث لم يعد الواقع هو ما وقع وانتهى حسب، بل إن تعيين الواقع بات تماماً مثل تعيين الإلكترون عند هايزنبرغ، أي عندما تثبّته للدراسة «بنيوياً» تفقد سرعة تغيراته «تاريخيته» وعندما تحدد تغيراته وحركاته، تفقد ثباته وموقعه، أي أننا لا نفتأ نعيّن الواقع حتى يهرب منا الواقع ذاته الذي قمنا تواً بتعيينه، لأن تعيينه، لا يعدُّ إلا ضرورة منطقية لدراسته، وليس تعييناً أبدياً وثابتاً لحاله الأنطولوجي. فالوجود محكوم بالصيرورة، والتغيّر محكوم بالضرورة.
جاء فلاسفة العلم في منتصف القرن العشرين، لكي يحطموا تلك الثقة المطلقة بالعلم التي طغت على بدايات القرن، فاعتبر كارل بوبر أن مبدأ قابلية التحقق الذي جاءت به المدرسة الوضعية للطعن بأهمية الفلسفة، لا يلغي الفلسفة والميتافيزيقا حسب، بل يلغي العلم ذاته. وضرب مثاله الشهير حول البجعة السوداء التي ألغت بديهية «علمية» سادت لمئات السنين حول أن «كل البجع أبيض» ثم استبدل بوبر مبدأ قابلية التحقق verifiability الذي جعله الوضعيون شرطاً للعلم، بمبدأ قابلية التكذيب falsifiability الذي يرسم حدود البحث العلمي ويجعل كل ما ليس قابلاً للدحض ليس علماً. ثم أطلق توماس كوهن أفكاره حول باراديغمات العلوم التي تحدد «بنية الثورات العلمية» فأنتج ثورة في رؤية العلم ذاته. ثم عزز غاستون باشلار ما قاله كوهن عبر إضافة أفكاره العلمية/الفلسفية حول القطائع الإبستمولوجية/المعرفية التي تحكم تاريخ العلم، ثم أطلق مقولته الشهيرة حول أن «تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه».
وأما في العلوم الإنسانية فقد دخلت الأيديولوجيا لتعكر صفو الحيادية العلمية المزعومة، حيث لم يعد العلم متعالياً عن الأيديولوجيا بالمطلق كما كان الظن سابقاً، بل باتت الأيديولوجيا متداخلة في صلب العلم ذاته. وتلك المناهج والتصورات «المنظورية» و»الإبستيمية» باتت أكثر وضوحاً وقبولاً بعد ميشيل فوكو الذي قلب الفلسفة الكانطية رأساً على عقب. إذا كنا سنصل للموضوعية objectivity عبر دراسة الذاتية subjectivity عند كانط، فقد دلل فوكو على كم ذاتية وذاتوية توجد في كل دراسة تدّعي الموضوعية. وبعد دراسات فوكو حول العيادة والجنسانية والجنون، السجن والمستشفى والمدرسة والثكنات العسكرية، والأهم بعد مفهومه الأرأس حول السلطة الحيوية أو الـ biopower، لم يعد العلم بعيداً عن التحيّز أو خالياً من السلطة، بل بات هو الإبستيم الذي ينتج معايير السلطة ذاتها. السلطة التي تحدد للإنسان كيف يجب أن يعيش وتفرض شروط العيش السليم. السلطة التي تبدأ في البيولوجيا، ثم تستخدم البيولوجيا لتنقل أحكامها إلى السوسيولوجيا، ومن السوسيولوجيا تنتقل أوتوماتيكياً إلى الأيديولوجيا، ومن ثم تنتهي في السياسة وإدارة مؤسسات الدولة من المدرسة إلى الجامعة، ومن المستشفى إلى السجن. ولهذا بات العلماء؛ بوعي أو دون وعي، هم جنود تلك السلطة الأوفياء، حيث الطبيب شريك الضابط، وأستاذ المدرسة شريك دكتور الجامعة. وبالجملة انخرط جنود السلطة المعرفية أولئك في معركة المراقبة والمعاقبة تجاه الإنسان المعاصر، لضبطه وترشيده ومنع انفلاته من الحكم، وللسيطرة عليه بدلالة تحريره. ذلك ما سمّاه فوكو «مجتمع الانضباط» قبل انتقاله إلى صيغة أكثر تعقيداً مع ولادة «مجتمع التحكّم» الذي يفصّل فيه دولوز.
اليوم، في عصر الالتباس والـambiguity، عصر سقوط السرديات الكبرى وصعود القَبَليَّة الدولية والـtribalism. عصر الضياع الهوياتي وسقوط «المعاني الكبرى المقدسة» وفقدان المعنى… ليست الفلسفة نوعا من الترفيه، بل حاجة بشرية لخلق المعنى الفردي والجمعي، وحدّْ التطور العلمي الأعمى (بالمعنى الإيطيقي لا بالمعنى الأخلاقي) وإنتاج القيم التي تربطنا بغيرنا من الكائنات البشرية وغير البشرية التي تشاركنا هذا الكوكب. فإذا ما كان العلم هو دين الإنسانية الجديد، فليس سوى الفلسفة ما يمكنه مواجهة الدين، وأشّكَلة التدين، ونقد العقل الديني، بغض النظر عن القناع الذي يرتديه.
كاتب سوري
القدس العربي