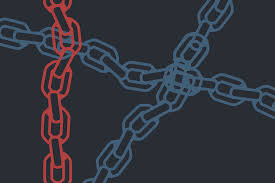الحرب الوظيفية/ ياسين الحاج صالح

يجد الدارس السوري المهتم بكتابة شيء يتصل بتاريخ سورية في الحقبة البعثية، والأسدية بصورة خاصة، نفسه في موقع غير ملائم، ليس قياساً لنظرائه الغربيين، وليس للدراسين الإسرائيليين، بل حتى قياساً لبلد عربي كان بمثل مستوى سورية من التطور حتى وقتٍ قريب، مصر، التي لم تشتهر خلال سبعة عقود ماضية على الأقل بمستوى مُميَّز من حرية التعبير. لكن مصر عرفت خلال تلك العقود ضرباً من تداول السلطة تكفَّلَت به المقادير الإلهية أو تحركات قطاعات من المجتمع المصري، نخبوية أو شعبية، أثمرت قدراً من تغيّر سياسي مسقوف، إلا أنه سمح بالنظر بقدر أكبر من الحرية إلى العهد السابق له. زمنُ السادات أتاحَ نقدَ زمن عبد الناصر وتقييماً مغايراً لأوجه من أداء المؤسسات والشخصيات السياسية والعسكرية في تلك الحقبة المؤسِّسة. وهو ما تحقَّقَ بقدرٍ ما بعد اغتيال السادات، حيث أُتيح لسياسيين أو عسكريين سابقين أو لصحفيين وباحثين في سنوات حكم مبارك الطويلة الكتابة عن أوجه مختلفة من سنوات السادات الأحد عشر في الحكم. ولم يطل الأمد بحقبة الثورة كي يمتحن هذا الميل العام، لكن لعله يمكن الكتابة اليوم عن عهد مبارك ذاته، ونحو عامين ونصف من الثورة وحكم مرسي، دون كثير من الرقابة الذاتية. لا شيء يقارب ذلك في سورية التي تحكمها السلالية الأسدية منذ عام 1970، وقبلها كان مؤسِّس السلالة، حافظ الأسد، وزير الدفاع خلال حرب حزيران (ومنذ شباط/ فبراير 1966). بعد «الهزيمة»، بحسب ما أصرَّ صادق جلال العظم وياسين الحافظ على تسمية ما جرى في تلك الحرب الخاطفة، لم يُكتَب شيءٌ عن الحرب ذاتها، فلم يعرف أحد ماذا جرى، وكيف جرى، ولماذا جرى ما جرى، ومن المسؤولون؛ كما لم يحاسب أحد، ولم يَستقِلْ أحد، ولم ينتحر أحد. بالعكس، كافأ وزير دفاع الهزيمة نفسه بالاستيلاء على السلطة في البلد بعدها بثلاث سنوات ونيّف. وهو ما أقام استمرارية سياسية وتاريخية بين الهزيمة والحكم الأسدي.
وخلال هذه السنوات الطوال التي تُعادل كل عمر أكثرية السوريين (96% من السكان دون الستين، أي أصغر من الحكم البعثي الذي بدأ في آذار/مارس 1963)، كانت السلطة مُنتِجة لمعرفة لا توجد فيها هزيمة حزيران كموضوع تفكير ونقاش ومُساءلة. تُقرِّرُ هذه المعرفة أن بلدنا مستهدف، أن أعداء أقوياء لا يكفون عن التآمر علينا، مؤامرات نواجهها بوحدتنا الوطنية الصلبة التي تتمثّل في «الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة التاريخية الحكيمة» لإحباط خطط الأعداء، مع ما يقتضيه ذلك من تضحيات جسام وصمود مستمر. ورغم انتصارنا الدائم على المؤامرات بفضل قيادتنا الاستثنائية ووحدتنا الوطنية، إلا أن علينا أن نبقى صامدين، فتاريخنا هو صمود ننتقل منه إلى صمود فَإلى صمود. هذه المعرفة تتكفّلُ بنشرها وتعميمها أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمقروءة، المُحتكَرة من قبل النظام أو من قبل مَحظيين له يزايدون عليه. وتُعمَّم كذلك في الكتب المدرسية التي اكتملَ تبعيثُها في حقبة حافظ. بالمقابل، لم تكد توجد سياقات منافسة لإنتاج المعرفة عن سورية وشؤونها، وحتى المثقفون الأكثر نقدية اعتصموا بالعموميات، فكانوا يتكلمون على «الوطن العربي» أو «الأنظمة العربية» أو «بلدان العالم الثالث» أو «البُلدان المتخلفة»، وكانوا على كل حال ينشرون نتاجهم في بيروت.
«حرب تشرين التحريرية التي قادها السيد الرئيس حافظ الأسد» وقعت ضمن هذا الإطار الذي ينبغي القول إنه كان يتكون وقتها، وسيترسَّخُ بعدها عبر التفاعل بين تطلعات الحاكم الجديد نسبياً عند نشوب الحرب إلى حكم يدوم بلا نهاية وبين التجارب الواقعية.
كانت محاربة إسرائيل بغرض تحرير الأرض أو الحيلولة دون استقرار الاحتلال نقطة إجماع سورية (ومصرية، وفلسطينية)، وغايةُ ما قد ينشأ من مجادلات كان يتصلُ بأسلوب الحرب: حرب التحرير الشعبية التي دافع عنها في أواخر الستينات ومطالع السبعينات صادق جلال العظم ومنظمات فلسطينية، أم حرب نظامية تعبئ طاقات الشعب كله، مثلما رأى إلياس مرقص وياسين الحافظ؛ وهل ينبغي خوضها الآن وفي كل وقت، أم يجب أن تُعَدَّ للأمر عدته ويجري كسب بعض الوقت بهدف إعادة بناء القوات المسلحة، فلا بأس بـ«استئخار المواجهة» مثلما فضَّلَ ياسين الحافظ، متفهماً من هذا المنظور موافقة جمال عبد الناصر على مبادرة روجرز 1969.
وحين وقعت الحرب في مثل هذا اليوم قبل خمسين عاماً، حظيت بالفعل بإجماع وطني واسع وحماس شعبي كبير. نحن بعد جيل واحد من استقلال سورية، ومن إقامة إسرائيل، ولا تزال وقائع ربع القرن السابق في أذهان القطاعات المهتمة بالشؤون العامة في البلد، ولا تزال الروحية القومية التقدمية، روحية التحرُّر الوطني والنضال من أجل الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار وبناء الاشتراكية قوية ومهيمنة.
لكن لموضعة حرب تشرين (أكتوبر) في إطارها التاريخي السوري، يَتعيّنُ أن نحاول تَبيُّنَ موقعها في بنية الحكم الأسدي على ما سترتسم في العقد الأول من حكم حافظ الأسد، وتترسخ في العقد الثاني، وتثمر تأسيسَ سلالة حاكمة في نهاية عقدها الثالث.
ثلاثة حروب في عشر سنوات
حرب تشرين (أكتوبر) هي الأولى بين ثلاثة حروب عرفتها سورية في العقد الأول من حكم حافظ الأسد، الذي سيوصف بعدها بأنه بطل التشرينيْن: تشرين الثاني، نوفمبر، 1970 الذي هو تاريخ انقلابه المُعمَّد باسم «الحركة التصحيحية المباركة»؛ ثم حرب تشرين الأول، أكتوبر، ذاتها. وحين تُعَدَّد «منجزات» هذا العهد، كانت تأتي «حرب تشرين التحريرية» في مقدمتها، ومعها «تحرير القنيطرة» و«تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر»؛ تسبقها زمنياً «الجبهة الوطنية التقدمية» 1972، وهي إطار للحياة السياسية (والأصح: للموت السياسي) يضم حزب البعث بأكثر من نسبة الثلثين التي تكفي لاتخاذ أي قرارات (لم يُعرَف في تاريخ الجبهة اعتراض على قرار من النظام)، مع أحزاب تابعة شيوعية وقومية عربية؛ ثم «مجلس الشعب»، ونظام «الإدارة المحلية»، و«الدستور الدائم» الذي صدر عام 1973 قبل الحرب بشهور. خطاب «المنجزات» كان شائعاً جداً في سنوات حكم حافظ الأسد، وهو يؤشر على الحاجة إلى ما سمَّاها غسان سلامة «شرعية إنجازية»، تُعوِّضُ عن ضعف أشكال الشرعية الأخرى، التقليدية أو الكارزمية أو العقلانية البيروقراطية، بحسب تصنيفة ماكس فيبر الشهيرة. لكن عدا عن المبالغة في «المنجزات»، وعن اقترانها بتهوين دائم من النواقص والصعوبات، بل الكوارث، فإن خطابها كان متمركزاً جداً حول الرئيس وشخصه، حتى ليمكن اعتباره شخصياً المُنجَز الوطني الأعظم. كان الرئيس أهم من تلك الأجهزة والانتصارات كلها، ومع الأيام أهمَّ من البلد بما فيها من مدن ومن شعب وثقافة وأديان وكل شيء.
الحرب الثانية هي التدخُّل السوري في لبنان في صيف 1976، وقد استهدف أول ما استهدف تحالف منظمة التحرير الفلسطينية مع الحركة الوطنية اللبنانية. جاء التدخل بضوء أخضر أميركي يشرح تفاصيله باتريك سيل، الصحفي البريطاني الذي كان مُعجَباً بحافظ الأسد، في كتابه الأسد والصراع على الشرق الأوسط. لقد قيلَ لحافظ إن إسرائيل ربما تتدخل إن لم يتدخل هو بقواته في مواجهة التحالف الفلسطيني اللبناني، الذي كان صاحب الكلمة العليا في ذلك الوقت الباكر من الحرب اللبنانية، وهو ما فَهِمَ منه الرجل، الذي كان في حكم سورية منذ نحو ست سنوات وقتها، ما ينبغي أن يُفهَم من الترحيب بتدخُّل نظامه. كان محادثات فصل القوات اللاحقة لحرب تشرين، وقد أدارها هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، قد فتحت خطوطاً بين النظام والأميركيين بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974 (جرى قطعها عام 1967)، ويبدو أن الأميركيين وجدوا في حافظ الأسد دكتاتوراً قوي العزم يضبط البلد الذي يحكمه بقبضة حديدية، وسياسياً واقعياً يفي بتعهداته في مجال العلاقات الدولية، وكان سبق له طوال سنوات أن ضبط جبهة الجولان فلم يسمح بأي مقاومة فلسطينية أو سوريّة عبرها. هذا رجل مناسب لضبط لبنان كذلك.
وهو الضبط الذي نال غطاءً عربياً كذلك، وتدخَّلَتْ القوات السورية في البلد الصغير الجار في إطار سُمّيَ في حينه «قوات الردع العربية»، تَشكَّلَ أساساً من القوات السورية.
في السنوات اللاحقة تقلَّبت أدوار القوات السورية كثيراً، وطوال نحو 30 عاماً من تَحكُّمِها بلبنان، لم يكد يبقى تشكيل في البلد الصغير لم يكن النظام السوري في حرب معه أو في تحالف معه يوماً، ربما باستثناء ياسر عرفات ومنظمة فتح التي بقيت العلاقة معها ما بين جافّة وعدائية، بفعل مقاومتها إلحاق القرار الفلسطيني بالنظام السورية.
على أن الحرب اللبنانية كانت المُختبَر الذي جرى فيه «تخليق الدور الإقليمي لسورية»، وهو يتمثّل في علاقات بين النظام السوري وتشكيلات ما دون الدولة في البلدان المجاورة، لبنان وتركيا والعراق وفلسطين.
سُمِعَت أصوات معترضة في الداخل السوري على التدخّل السوري في لبنان، وأدانه مثقفون سوريون في بيان وقَّعوا عليه وقتها، وكان من ضمنهم فاروق مردم بيك وبرهان غليون، فحُرِما من جوازي سفرهما، ولم يعد أولهما إلى سورية قطّ منذ عام 1973، فيما لم يعد الثاني حتى أواخر التسعينات. كذلك تحوَّلَ تنظيم شيوعي تمخَّضَ عنه انشقاق الحزب الشيوعي السوري عام 1972 (الحزب الشيوعي- المكتب السياسي) نحو معارضة صريحة للنظام بِدءاً من ذلك التدخّل. وبرز شعور منتشر بأن البلد تُدَار كالمزرعة، حتى بدون ما يظهره أصحاب المزارع من مسؤولية حيال مَزارعهم. وكان مزيج من الفساد والتسلّط الوقح يعمّ وينشر الخوف بين السكان، ولم تثمر محاولة فوقية لـ«التحقيق في الكسب غير المشروع»، وهو عنوان لجنة أقامها النظام عام 1978، وهذا لأن الدولة بالذات كانت تحولت إلى «لجنة لتحقيق الكسب غير المشروع».
كانت الفورة النفطية التي أعقبت حرب تشرين الأول قد نفعت الحكم الأسدي في سورية وحكم السادات في مصر بعوائدها لعدة سنوات، وعززت في سورية استقلال النظام عن المجتمع السوري مثلما هو المفعول المُعتاد للدخول الريعية. باتريك سيل المذكور سابقاً يذكر قفزةً في عدد المليونيرات السوريين من عشرات إلى 736، بعد دزينة واحدة من السنوات على حكم حزب البعث العربي الاشتراكي.
والأرجح أن مزاجاً إسلامياً طَوَّرَ مواقف أكثر جذرية حيال حكم حافظ الأسد بفعل تقاطع الترسّخ الطائفي للنظام مع تسلطيته المتفاقمة ومع تدخله في لبنان، مع بوادر تحول راديكالي في الإسلامية، يتطلع إلى استيلاء إسلامي، انقلابي أو مسلح، على السلطة. بعد قليل أخذت تحدث اغتيالات متقطعة لمقربين من النظام، عسكريين ومدنيين، لن يُعرَف إلَّا بعدَ بضع سنوات أن وراءها تشكيلاً إسلامياً متشدّداً اسمه «الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين». كان مؤسِّس هذا التشكيل مروان حديد قد قتل في السجن عام 1975، فصار مُعادِلاً سورياً لسيد قطب في مصر (وإن دون الأعمال الفكرية لقطب).
الحرب الثالثة هي حرب أهلية سورية، بؤرية (حلب وحماة وإدلب، وبقدر ما حمص واللاذقية، وتململات هنا وهناك…) وليست شاملة، تمثَّلت القفزة النوعية نحوها بمجزرة ارتكبتها «الطليعة المقاتلة» في حزيران 1979، ذهب ضحيتها عشرات تلاميذ الضباط العلويين، ربما ثمانين، في مدرسة المدفعية في حلب، قادها ضابط منتسب سرّاً لهذا التشكيل المتطرف. كنا ندخل زمن الصراع الطائفي المُطلَق بعيون مفتوحة، وقد فاز به النظام وإن بكلفة هائلة. وبموازاة هذا الصراع جرى سحق اعتراضات سياسية ونقابية، تمخَّضت عن عشرات ألوف المعتقلين، وهذا مع ثورة في الاعتقال والتعذيب والاعتداء على الناس في الشوارع، فضلاً عن مجازر متنقلة في مواقع التمرد أو المشتبه بتعاطفها مع المتمردين على النظام، بلغت ذروتها في مذبحة حماة في شباط (فبراير) 1982، حيث يُقدَّر أن ما بين 20 و30 ألفاً من سكان المدينة قد قتلوا خلال شهر من محاصرتها وعزلها عن العالم، وذلك إثر تمرد محلي لإسلاميين من المدينة.
لقد سهَّلَ فوز النظام في جولة الحرب الأهلية الناقصة هذه لحافظ حكم مجتمع مُرتاع، ثم توريث السلطة بعد نحو عقدين. هذا أكبر تحول سياسي جرى في تاريخ سورية، وهو ما جعل منها البلد العربي الأوخم عاقبة: فقد جرى تحول كبير، لم يحدث مثله في مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق (وقد ساور التوريث خواطر حكامها المزمنين كلهم)… محمولاً على أكتاف مجازر وتعذيب وفظائع مَهولة. ودون تطوير إحدى شرعيات فيبر الثلاث، لا يستطيع نظام الوريث ادعاء منجزات تذكر. لعلّه من هذا الباب جادَ التطوع المتحمس في الحرب ضد الإرهاب بعد الثورة، والاستثمار في مظهر بشار وزوجته «الحداثي». ثمة انحطاط في الشرعية يوازي الانحطاط في السلطة، وقد سهله في كل مكان نظام دولي متمركز حول «الحرب ضد الإرهاب».
تَوَّجَ التوريث خروج سورية من خانة البلدان التحديثية التنموية التي تُديرها نخب تسلطية، مثل كلّ ما ذُكِرَ للتو من بلدان عربية، وهذا دون أن تدخل خانة البلدان التي تقودها سلالات عائلية تحوز قدراً من شرعية تقليدية، وربما شرعية كيانية بفعل تشكُّل السلالات مع الكيانات التي تحكمها مثل دول الخليج والأردن والمغرب. هذا ما يجعل تاريخ سورية خلال الحقبة الأسدية عنيفاً وحشياً وغير مستقر، وصولاً كما نعلم إلى تأجير البلد لدولتين متطرفتين قومياً وعدوانيتين: إيران وروسيا.
بنية الحكم الأسدي
لكن لنَعُد إلى حروب العقد الأول الثلاثة، لكون بنية النظام تشكلت وترسخت عبرها.
الحرب الثالثة، الحرب الأهلية، ربحها النظام، وصارت مكوناً بنيوياً له، مترسِّخاً جهازياً في أجهزة أمنية مُطيَّفة، وفي تشكيلات عسكرية ذات وظيفة أمنية (وقتها، سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد والوحدات الخاصة بقيادة علي حيدر والفرقة الثالثة بقيادة شفيق فياض والحرس الجمهوري بقيادة عدنان مخلوف). ينطوي هذا المكون البنيوي مُحتجِباً في أوقات الاسترخاء، وينبسط حين يواجه النظام أزمة يُقدَّر أنها تهدد وجوده مثلما حدث بعد الثورة عام 2011. اليوم، المخابرات هي المخابرات، وإن مع صعود لجهاز المخابرات الجوية بعد الثورة، أما التشكيلات العسكرية الأمينة فأشهرها اليوم الحرس الجمهوري وفرقة ماهر الأسد الرابعة. هذه جوهرياً أذرع حرب أهلية مستمرة.
على أن الجيش كله ذا وظيفة أمنية، حامٍ للنظام وليس للبلد، على ما أخذ يظهر منذ التدخل في لبنان، وطوال العقود الماضية. فإذا كان «الجيش العربي السوري» هو الجهاز الذي يجسد أثرَ حرب تشرين في بنية النظام، فإن التاريخ اللاحق لهذا الجيش الذي دمَّرَ مدناً وبلدات سورية، ومخيمات فلسطينية، عديدة منذ سكتت مدافعه على جبهة الجولان، هو بمثابة إثبات بمفعول راجع للصفة الوظيفية لتلك الحرب.
الحرب الثانية، الحرب اللبنانية، أسَّست لما يمكن أن تُسمّى الدولة الخارجية، الدولة المتجهة نحو الخارج، تبني خطوط دفاعٍ خارج البلد وتجد نفسها في بيتها في صحبة منظمات ما دون الدولة أكثر من الدول: حزب الله ومنظمات لبنانية متنوعة، حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) من تركيا ومنظمات أخرى أصغر، مزيج من منظمات كردية وشيعية ويسارية عراقية أيام صدام حسين، منظمات فلسطينية متنوعة، وبصورة مغايرة شبكات سلفية جهادية بعد الاحتلال الأميركي. جديرٌ بالاهتمام أن تصدير العنف بين أواسط سبعينات القرن العشرين والثورة السورية انقلب إلى استيراد للعنف بعد الثورة، وأن منظمات ما دون الدولة في البلدان المجاورة تدفقت إلى سورية، لتحارب مع النظام في الغالب (أو ضده وضد الجميع من قبل السلفية الجهادية)، بِدءاً من صيف 2012، ليكون تاريخ سورية خلال نحو أربعين عاماً عبارة عن نبضة كاملة إن جاز التعبير: انقباض يضخ العنف خارجاً، ثم انبساط وضغط سلبي في الداخل السوري بفعل تضعضع النظام بعد صيف 2012 يجتذب العنف ما دون الدولتي إلى الداخل، وهذا قبل أن يستدعي العنف الدولتي، الروسي (في خريف 2015).
أذكر هذه الاعتبارات غير المتّصلة مباشرة بحرب تشرين الأول (أكتوبر)، أُولى حروب العقد الأسدي التأسيسي، للقول إن هذه الأخيرة تجد مكانها ومعناها، ووظيفتها، في هذا المسلسل العنفي. فالحوادث التاريخية لا تحتفظ بالدلالة نفسها والوظيفة نفسها أياً تكن البنية التي تندرج ضمنها ومدى ترسخ هذه البنية في التاريخ. بموقعها في بنية عنف ناشئة ترسَّخت عبر العقود، صارت حرب تشرين ما لم تَكُنه وقت وقوعها: حرباً وظيفية، يتمثل دورها في إسباغ شرعية ما على نظام معني بدوامه أولاً وأساساً، وليس بالأهداف المُفترَضة للحرب ذاتها.
لكن ماذا جرى في الحرب نفسها؟ قبل كل شيء كانت حرباً خلافاً لم جرى قبلها بست سنوات وأربعة أشهر، المبادرة فيها جاءت من طرفنا بالتنسيق مع مصر، ووسطَ تأييد شعبي كبير، ومُساندة عربية مُخلِصة أو مُحرَجة. وكان أداء الجيشين في البداية معقولاً، لكن البنية التنظيمية العسكرية السياسية لا تسمح بحرب حديثة جدية مديدة، ولا الحدود الهشّة لوطنية النظامين، وبالتحديد أولوية بقائهما على العمل المتّسق لتحقيق أي أهداف وطنية عامة. بعد قليل أخذنا نخسر المعركة. في مصر جرى تثبيت وقف إطلاق النار على مواقع للجيش المصري شرق القناة، وإن مع اختراق إسرائيلي خطير غربها: ثغرة الدفرسوار. في سورية لم نحتفظ بأي شيء مما جرى تحريره من المنطقة المحتلة، وبالعكس وسَّعت إسرائيل من احتلالها. هذا لم يُقَل بطبيعة الحال. عرفه بعض السوريين من المعاينة المباشرة، وعرفه المهتمون بالتدريج فيما بعد.
لكن أَسقطت وسائط الدفاع الجوي السورية عشرات الطائرات الإسرائيلية (المئات بحسب البلاغات الرسمية)، ووقع في الأسر خمسة وستون جندياً إسرائيلياً، بينما قُتل منهم مئات. وأسرت إسرائيل فوق 700 من الجنود السوريين.
بعد مفاوضات طويلة نسبياً، وزيارات متكررة لهنري كسينجر، جرى وقف إطلاق النار في أيار (مايو) 1974، وتبادل الأسرى، وضمنت اتفاقية فصل قوات تسليم إسرائيل شيئاً لحافظ الأسد بطلب وضغط من الوزير الأميركي، تمثَّلَ في مدينة القنيطرة المُدمَّرة والخالية من السكان والمُفتقِرة إلى القيمة الاستراتيجية. مرتفعات الجولان المنيعة والغنية بالمياه ظلت بيد إسرائيل التي ألحقتها بها عام 1981.
هذه الحرب الأولى بين حروب العقد الأول الثلاثة خسرناها. تجنُّبُ الحرب مع إسرائيل صار عنصراً بنيوياً في النظام. ليس في هذا أي خطأ، بالنظر إلى موازين القوى والوضع التاريخي لبلداننا في العالم مقابل وضع إسرائيل ذات العمق الاستراتيجي الغربي الذي لا يُقارَن نوعياً ولا كمياً بالدعم السوفييتي وقتها. أنور السادات كذلك استنتج أن تلك الحرب هي «آخر الحروب»، وسوَّغَ الأمر بأنه لا يستطيع محاربة الولايات المتحدة. لكن السادات اتجه انفعالياً إلى مصالحة مُتعجّلة مع الكيان الإسرائيلي المعتدي، فيما امتنع حافظ الأسد عن الحرب، لكن بنية نظامه وخطابه، وحالة الاستثناء التي فرضت منذ اللحظات الأولى للانقلاب البعثي الأول، استمرّت حربية دون تغيير؛ وبدا أننا في حالة حرب مستمرة، مدعوين بالمقابل إلى صمود مستمر، وسحق مستمر لمؤامرات خارجية وداخلية تضع النظام، وأجهزة مخابراته بخاصة، في موقع المَرجِع الأعلى لوطنيةِ السوريين. وهذا مع إغلاق مستمر للملعب السياسي الداخلي. كان باتريك سيل الذي تقدمت الإشارة إليه قد نوَّه بتحويل سورية من «ملعب إلى لاعب»، مُغفِلاً إغلاق الداخل السوري سياسياً، أي إلغاء المجتمع السوري كإطار تَعدُّد في التفكير والرأي والفعل. في واقع الأمر هناك استمرارية بين تحويل سورية من ملعب إلى لاعب في عهد الأب، وارتدادها من لاعب إلى ملعب في عهد الابن، استمرارية تتمثّل في إحالة السوريين إلى متفرجين في أحسن الأحوال، وملعوب بهم وبتمايزاتهم في أسوئها، على ما أخذنا نرى بعد الثورة السورية.
لكن لماذا تصرَّفَ النظام كما لو أن الحرب مستمرة؟ لأن بنيته كنظام حكم مسلّح يقوم على الاستثناء والأبد بنيةٌ حربية، أي كذلك لأن الحرب حاجة دائمة من حاجات البنية الاستثنائية. ليس سبب حالة الاستثناء هو الحرب، بل العكس تماماً هو الأصح: الحرب حاجة بنيوية مستمرة من أجل الاستثناء الذي صار قاعدة لا تتغير. الشرط الحربي الدائم ظهرَ بجلاء تام بعد الثورة السورية، حيث أُلغيت حالة الطوارئ عام 2011، لتحلَّ محلها قوانين مكافحة الإرهاب التي هي الشيء نفسه وبقسوة أشد. الحرب التي تُسوِّغُ حالةُ الاستثناء نفسها بها تغيرت من مواجهة «العدو الإسرائيلي» إلى «الحرب ضد الإرهاب»، أي ضد معارضي النظام.
نحن وإسرائيل والأرشيف
هل هناك أرشيف سوري محفوظ في مكان ما لحرب تشرين؟ ربما. هل هناك فرصة للاطلاع عليه يوماً ما؟ إن وجدت الفرصة، فليس قبل انطواء الحقبة الأسدية. من خصائص بنية الحكم الذي وقعت سورية تحته منذ ستين عاماً أن الدولة تبدو مُنظَّمة سرية خاصة، وليست موطن العمومية والعلانية الذي قد يحيط بعض الشؤون العامة بالسرية، لكن في إطار قانوني يكفل كشف النقاب عنها بعد حين. وهذا التكوين وثيق الصلة بكون «الدولة» كذلك هي المنظمة الأكثر فئوية وعنفاً، أي في واقع الأمر بأننا حيال منظمة ما دون دولة خاصة، مثل حزب الله مثلاً، مستولية على الدولة السورية العامة. وهي بهذا التكوين عدوٌ للذاكرة، للوثيقة، للأرشيف، فوق عدائها للرأي والمبادرة والحرية. معادية بخاصة لأن يُكتَب تاريخها، ولو من أمثال باتريك سيل أو أشباهه من صحفيين وأكاديميين غربيين (كتاب سيل كان ممنوعاً من التداول العلني في سورية).
غياب الوثيقة ليس الشكل الوحيد لعلاقة بين المعرفة والسلطة تفقد فيه الأولى أي استقلال ذاتي. أهم منها تبعية الجامعة، وعدم وجود صعيد معرفي مستقل، أو حتى رأي مستقل، وهو ما يجعل من الانشقاق السياسي الشكل الوحيد لإمكان تقديم معرفة أخرى، مستقلة بعض الشيء.
قبل أسابيع قليلة، أخذ الأرشيف الإسرائيلي لحرب 1973، وتُسمَّى حرب يوم الغفران في إسرائيل، يصير متاحاً لعموم الباحثين بحسب قانون إسرائيلي، يُتيح وثائق الدولة للعموم بعد خمسين عاماً، والأرجح أن باحثين إسرائيليين سيستندون إليها لإعادة كتابة تاريخ هذه الحرب. ندين لمثل هذا القانون الإسرائيلي بأعمال المؤرخين الإسرائيليين الجدد، الذين اشتغلوا بدءاً من عام 1998 على رواية قصة قيام إسرائيل، وفَنَّدوا الرواية الصهيونية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بأن هؤلاء تركوا موطنهم تلبية لأوامر القيادات العربية. أمثال آفي شلايم وإيلان بابيه وآخرين، طَوَّروا مواقف جذرية من الكيان الإسرائيلي ككل بالاستناد، جزئياً على الأقل، إلى معارف أتاحها الأرشيف الإسرائيلي. صحيح أن إنتاج المعرفة في إسرائيل بقي منضبطاً بمؤسسات الصهيونية وبإسرائيل بوصفها دولة يهودية ذات ارتباط خاص بالغرب، على ما يُظهِر بابيه في كتابه فكرة إسرائيل، تاريخ السلطة والمعرفة. لكن مُعادِلَ مركزية الصهيونية في إنتاج المعرفة لدينا هو مركزية النظام ورأسه الأسدي، وليس الوطنية السورية ولا القومية العربية. هنا لا تنحط المعرفة إلى إيديولوجيا، بل إلى دعاية وتهويل وكذب مستمر، وهذا بموازة انحطاط السلطة إلى حكم شخصي عائلي، والشرعية إلى… مَظهر حداثي.
لقد استطاعت إسرائيل صُنع مجتمع من أناس قدموا من مائة بلد، واستطاع الحكم الأسدي تمزيق مجتمع وتشريد سكانه في 127 بلداً (بحسب تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش»، مرصد حقوق الإنسان، صدر في مطلع 2022). لم يكن ذلك محتوماً بحال، لا يحتمه التاريخ ولا الجغرافية السياسية ولا الثقافة، ولا تحتمه حتى البنية المعروضة فوق، وإن كانت تُرجِّحه. ما حوَّلَ الترجيح إلى تحتيم هو خيارات طغمة حكم غير وطنية، تريد أن تستمر في الاستئثار بملكية البلد «إلى الأبد». مصير سورية البائس مكتوبٌ في هذا التطلع الشاذ أكثر من أي شيء آخر.
موقع الجمهورية