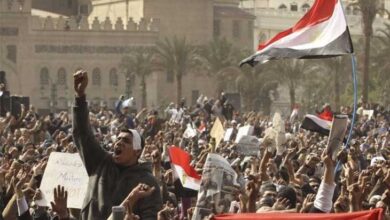خدعة التبسيط وبؤس الجذرية/ راتب شعبو

حتى وقت غير بعيد، كانت الاشتراكية، بالنسبة إلى كثيرين، هي الكلمة السحرية التي يمكنها الخروج بالمجتمع من كل المشكلات، وحين بدا طريق “التحويل الاشتراكي” طريقًا إلى النهب والإفقار والفشل الاقتصادي، فضلًا عن القمع المعمم، كان اليساريون يعزون السبب إلى نقص الالتزام بالاشتراكية، فيقترحون أنفسهم بديلًا عن السلطة الناقصة الاشتراكية، لكي يطبّقوا الاشتراكية الحقيقية أو الجذرية.
لم تكن الاشتراكية تعني أكثر من إلغاء الملكية الخاصة فوق حدود معيّنة، أو إلغائها بشكل تام أو “جذري”، بوصفها “مصدر الشرور”، وبدء التخطيط الاقتصادي. على هذا كانت الاشتراكية، أو على الأقل “بداية الاشتراكية”، في المتناول ما إن يصل الاشتراكيون إلى السلطة. مبرر سعي الاشتراكيين إلى السلطة إذن هو أنهم سوف يتخذون مجموعة قرارات تتولى الدولة تنفيذها، فتضع يدها على المقدرات الاقتصادية للبلاد، وتسحبها من يد الأفراد المالكين الذين تحرّكهم، في أنشطتهم الاقتصادية، مصالحُهم الخاصة ضد المصلحة العامة، أو بصرف النظر عنها.
افتراض الأحقية السياسية للاشتراكيين كان يأتي، إذن، من إدراكهم “مصدر الشرور”، ومعرفتهم كيف يمكن الخلاص منه. بكلام آخر: كان هؤلاء يتخيّلون لأنفسهم مكانًا مهمًا، أو قل المكان الأهم، في اللوحة السياسية لبلدهم، ويستمدون شرعيتهم من وعيهم أو مما يعتقدونه الوعي الأعلى. فكرة الطليعة أو النخبة الطليعية جاءت من هنا، وكذلك فكرة الشرعية الثورية التي تقفز فوق خيار الناس.
وإذا تأمّلنا قليلًا هذا التيار، فسوف نجد أنه يختزل النضال السياسي في السعي إلى السلطة السياسية، من أجل تطبيق البرنامج الجاهز (التأميمات). وينطوي هذا على اختزال وتبسيط وتعالٍ (النظر للجماعات السياسة الأخرى بوصفهم أصحاب برامج وسياسات ضدّ مصلحة الشعب، أو بوصفهم لا يملكون من الوعي ما يكفيهم لإدراك مصلحة الشعب). ليس من شأن هذا الاختزال سوى رصف الطريق أمام سلطات مستبدّة تشبه سلطات التكليف الإلهي، فبدلًا من الحاكمية لله، نكون أمام الحاكمية للوعي، وكما يعتقد أصحاب الخيار الأول أنهم هم من يمثلون الله، يعتقد أصحاب الخيار الثاني أنهم يمثلون الوعي. في الحالتين، يكمن مصدر الشرعية خارج دائرة الشعب، وفي الحالتين، لا يوجد مقياس محدد يمكن محاسبة السلطة قياسًا عليه، لأن السلطة في الحالتين هي مرجعية ذاتها.
هذا النوع من السياسة “الجذرية” التي تُلغي الأرضية المشتركة يقتل فكرة السياسة، بوصفها ترجمة عليا لصراع القوى وتوازناتها، ليصبح مجرد ترجمة للنفي المتبادل، وفق ثنائيات قاتلة: جماعة تنسب نفسها إلى الإيمان وتنسب غيرها إلى الكفر، أو جماعة تنسب نفسها إلى العمل (الطبقة العاملة) وتنسب غيرها إلى رأس المال (أرباب العمل)، ولا توجد أرضية مشتركة تجمع هذه الثنائيات. ولا بد من ملاحظة جاذبية هذا التبسيط وهذه القطعية للجمهور في البلدان المأزومة اقتصاديًا واجتماعيًا. الأمر الذي يرشح القوى الجذرية التبسيطية إلى حيازة شعبية واسعة، وإلى أن تبدو معبّرة عن إرادة الشارع.
صحيح أنّ السلطات السياسية الأحادية و”الجذرية”، بدورها، في نسفها أي معارضة سياسية لها، وعدم قبولها بأقلّ من سيادتها التامة، هي من يدفع القوى المعارضة إلى “الجذرية”، أي إلى نفي السلطات المسيطرة، بوصفها المسؤول الوحيد عن كلّ بؤس المجتمع، إلا أن هذا لا يُغيّر حقيقة أن النفي المتبادل والتبسيط و”الجذرية” السياسية عقيمة المردود، بالرغم من كلفتها الباهظة. هناك ما يجب بناؤه، وهو الأرضية المشتركة، لكي يكون هناك صراع سياسي مجدٍ.
اليوم، أصبحت الديمقراطية هي الحلّ الذي شغل المكان الذي كانت تشغله الاشتراكية من زمن غير بعيد. النخب نفسها التي كانت تجد الحلّ في الاشتراكية، باتت ترى الحلّ في الديمقراطية، من دون أن تأخذ في الاعتبار الفارق المهمّ بين الفكرتين. كل ما جرى هو استبدال اللفظة، فبدلًا من الكلام عن قوى اشتراكية، بات الكلام يدور عن قوًى ديمقراطية.
لا يجري الانتباه إلى أنه مع الديمقراطية لم يعد الوعي الطليعي هو من يمنح النخبة “الديمقراطية” شرعيتها، فقد صار من المفترض العودة إلى الشعب لاكتساب الشرعية. الديمقراطية تضع الشعب فوق الطليعة، على الضدّ من فكرة الاشتراكية التي ترى أن الطليعة تعي مصلحة الشعب أكثر مما يعيها الشعب، ويحق لها بالتالي أن تنوب عنه من دون تفويض. لا شك أن في فكرة الديمقراطية كسرًا للاعتبار الذاتي العالي الذي اعتادت عليه الطليعة الاشتراكية.
وكذلك، ليست الديمقراطية برنامجًا لحزبٍ يطبّقها حال وصوله إلى السلطة، على غرار الحال في “البرنامج الاشتراكي”. على العكس، إن وصول أي حزبٍ إلى السلطة يجعل منه قوة معادية للديمقراطية؛ ذلك لأن الديمقراطية تحدّ من حرية السلطة التي من طبيعتها أن تسعى لتحجيم خصومها أو للخلاص منهم. ولا بدّ من اعتماد آليات تحدّ من ميل السلطة الحاكمة إلى التفرد والبطش بالقوى السياسية المعارضة. وهذا ما لا يوفره برنامج السلطة، إنما يوفره النظام السياسي المتوافق عليه. أي لا بدّ من لجم تسلّط الحزب الذي يستلم السلطة بطريقة ديمقراطية، وهذا اللجم يكون من النظام السياسي ككل (الحريات العامة، فصل السلطات، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية…) ومن الحضور الشعبي، أي لا بدّ من لجم الحزب الحاكم من خارجه.
إذا كان يمكن للاشتراكية أن تكون برنامج حزب، فإن الديمقراطية لا يمكنها ذلك، إنها بالأحرى حلٌّ وسطٌ بين أحزاب تفشل في نفي أو تهميش بعضها البعض، فتتفق على العودة إلى الشعب لكسب الشرعية حسب صناديق الاقتراع. على هذا؛ يبدو لنا أن تعبير “حزب ديمقراطي” بات اليوم ينطوي على تناقض داخلي. الديمقراطية هي صفة نظام سياسي تواضعت عليه قوى سياسية، وليست صفة للقوى السياسية نفسها.
لا يناقض قولنا هذا وجود أحزاب تحمل الوصف الديمقراطي في أوروبا وأميركا، فهذه الأحزاب حملت صفة الديمقراطية عندما كان هذا الوصف يحدد خيارًا طبقيًا بورجوازيًا، لم تعد له أهمية كبيرة اليوم.
كانت القوى الاشتراكية تفترض أن لها أحقية حاسمة في تاريخ مجتمعها، بوصفها قوى تقدمية تعبّر عن جهة حركة التاريخ. وينبع عن هذا أن من حق هذه القوى أن تستبدّ باسم مصلحة عامة مفترضة، أي أن تنسف الأرض المشتركة مع القوى الأخرى. في الديمقراطية، لا يوجد مثل هذه الأحقية الموهومة، ولا محيد عن بناء أرضية قيمية مشتركة تحكم الصراع السياسي. ومن دون هذه الأرضية؛ يبقى الصراع السياسي نفيًا متبادلًا في دائرة استبدادٍ لا ينتهي.
مركز حرمون