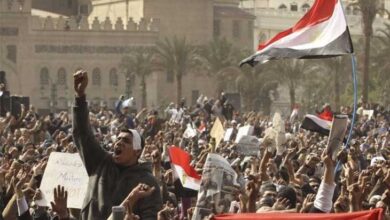كيف تفكك اليسار الثقافي؟/ عباس عبد جاسم
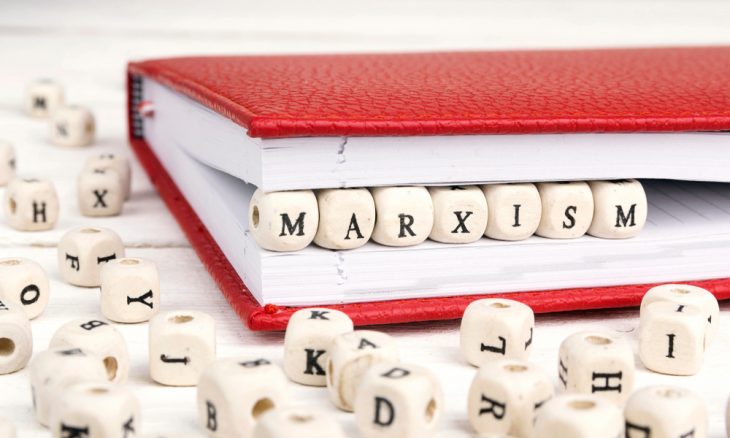
إن كان «المجال الثقافي» هو آخر ما تبقى من مشاغل اليسار الثقافي، فإن غياب الثقافة جعلت منه « أيديولوجية فقيرة» ( ياسين الحاج صالح/ أي يسار، أين، أي سياسات يسارية؟ / مجلة الآداب/ 2010)؛ هي جزء من أزمة مركبة في منظومة المثقف اليساري، من أهم مظاهرها موت «المثقف العضوي» بولادة مثقف العولمة الكوكبي أو المثقف الكوني.
لكن الشاغل المركزي لنا: كيف فشل اليسار الثقافي في مشروعه السياسي والأيديولوجي؟ والأهم من ذلك: لماذا لم يعد اليسار الثقافي منتجاً للتفكير الثقافي؟
وإن كانت أزمة المثقف اليساري ـ أزمة الفكر اليساري برمته، فإن المثقف اليساري لم يتحّرر من قيد «النص الماركسي» لكي ينتج التفكير الثقافي بحيوات ثقافية جديدة. ولعل أخطر ما في أزمة ثقافة اليسار؛ أن يظهر مثقف ما بعد مرحلة التحرّر الوطني في عالم مضطرب ـ كمثقف غير سياسي، وسياسي غير مثقف، وهما عاجزان عن إنتاج أي أفكار جديدة، الأمر الذي جعل كل منهما أسير عدمية ثقافية وسياسية. وإن كان غرامشي قد عالج مشكلة كيفية إنتاج «المثقف العضوي « من خلال الطبقة العاملة نفسها، فإن مقولة «المثقف العضوي» لم تعد نافعة أو فاعلة في سياق تحوّلات الحداثة وما بعد الحداثة، خاصة بعد تفكك البروليتاريا وسقوط النموذج الاشتراكي، حتى أصبح (المفكر التقليدي) نفسه هو (المثقف العضوي) للطبقة الحاكمة، وبذا توقف إنتاج هذا النوع من عضوية المثقف اليساري، ثم تغيّر مفهوم اليسار الثقافي بالتزامن مع الحرب الباردة باسم «اليسار الجديد» الذي يرتبط بالحياة اليومية. وإن كانت الحدود بين اليسار والديمقراطية والليبرالية إنمحت، حتى حلّت فكرة (المجتمع المدني) محل فكرة (الصراع الطبقي) فهل يعني ذلك: أننا إزاء يسار (توفيقي ـ تلفيقي) وإن كان كذلك، فإن اليسار الثقافي لم يعد يمتلك من عناصر القوة والتحدي والديمومة التي كان عليها في مرحلة «التحرّر الوطني» بما يجعله متجدّدا مع قوانين تطور حركة الواقع، لأنه محكوم بما يسميه عبد الحسين شعبان بـ»نستولوجيا» الحنين إلى الماضي. وإزاء نستولوجيا المثقف اليساري، يتساءل شعبان:
«أهي نهاية للمثقف العضوي حسب غرامشي؟ وهل بإمكان «تفاؤل الإرادة « تغيير» تشاؤم الواقع» أم ثمة عوامل ينبغي استكمالها لتحقيق ذلك؟ وهل صعود مثقف العولمة والمثقف النيوليبرالي هي نهاية للمثقف اليساري؟» (عبد الحسين شعبان/ نستولوجيا المثقف اليساري/ الحوار المتمدن/ 1 /5/2017).
إذن، هل ثمة مثقف أو مفكر أكثر ماركسية من ماركس لتمثيل الماركسية؟ حتى جاك دريدا، يعلن عن نفسه طفلا غير شرعي لماركس (الماركسية الغربية وما بعدها/ مجموعة مؤلفين / تحرير علي عبود المحمداوي/ ينظر: تقديم: كيف يمكن ان نفكر بعد ماركس/ أم الزين بنشيخة المسكيني) لهذا لا أحد يقول «أنا ماركس إلاّ على نحو تخييلي» (الماركسية الغربية وما بعدها/ مرجع سابق). ولكل ذلك، فإن اليسار الثقافي، هو في أحسن أحواله (صانع توافقات) بقدر ما هو (صانع تحالفات) بين أحزاب وأيديولوجيات سياسية ودينية. ونكرِّر ثانية: إن كان ما تبقى من مشاغل اليسار العربي هو «الشاغل الثقافي» فما الذي تبقى من المثقف اليساري؟ وإلاّ فما تعليل اضمحلال الفكر اليساري؟ بدلالة أنه لم يعد منتجا ًللأفكار، أي لماذا وكيف فشل اليسار الثقافي في مشروع التغيير السياسي والتجديد الفكري؟
لكن قبل تفكيك بنية الإخفاق، التي أفضت إلى مأزومية اليسار الثقافي، كان روجيه غارودي أول مفكر يساري من خارج المنظومة الاشتراكية؛ رفض «ديكتاتورية البروليتاريا « وقيادتها الرثة للسلطة والتحوّلات الاجتماعية، وقد قدّم فكرة «الكتلة التاريخية الجديدة» كبنية موضوعية بديلة لها، وتجمع هذه الكتلة بين الثقافة والاقتصاد والسياسة في سياق حداثي جديد.
من هنا بدأت إرهاصات التحوّل من الماركسية الاقتصادية إلى الماركسية الثقافية، خاصة بعد أن وضع اليسار الجديد ـ التصور الماركسي للتاريخ والسلطة في مساءلة جديدة.
وفي طور المجتمعات التي أخذت فيه الرأسمالية تقوم بإنتاج العقلنة، وتحويل التكنولوجيا إلى أيديولوجيا، لم تعد الرأسمالية هي الرأسمالية نفسها التي تحدث عنها ماركس، حتى أصبح الصراع، على حد تعبير جاك دريدا في كتابه «أطياف ماركس» يتشكل بعوامل جديدة (محركة ودافعة) نحو «التقنية العلمية».
ومن (لبْرلَة التكنولوجيا) تحديدا، بدأ إخراج الإرث الماركسي للاقتصاد السياسي من نظرية الصراع الطبقي إلى نظرية الليبرالية، وما تنطوي عليه من ديمقراطية قائمة على تحالف العولمة والسوق الحرّة. أما بورديو، فقد فكّك مقولة الصراع الطبقي، فالصراع الطبقي، وإن كان ينطلق أساسا من الرأسمال الاقتصادي، فإن ثمة رأسمال آخر يكشف عن صراع أكثر حدة وعمقا، حتى يتمايز داخل الطبقة الواحدة، هذا الرأسمال يسميه بورديو «الرأسمال الرمزي» وهو ذاته «الرأسمال الثقافي، هذا الرأسمال الذي يكشف عن آبيتوس، أي طبقة، يجعل الصراع الاجتماعي الطبقي قائما ليس على أساس التنافس على فائض القيمة، بل على استملاك الثروات المادية والرمزية (أكرم حجازي/ البنيوية التركيبية ـ فلسفة بورديو/ إنترنت).
ورغم هذه الانتقالات النوعية في كيفية إنتاج تفكير يساري أكثر استيعاباً لتحولات العالم، وصولاً إلى الطور الرابع للرأسمالية المتأخرة، فإن اليسار العربي الثقافي، كان ولا يزال مأسورا بأوهام الماركسية الاقتصادية، ومنها (الدين) بوصفه (وهماً) و(أفيوناً) نتيجة التقدير الخاطئ لماركس، وهو امتداد لخطأ لودفيغ فورباخ، في حين كان «طاقة هائلة» بعبارة لينين رجل الدولة.
ولكل ذلك، لم يفهم المثقف اليساري ماركسية ماركس، حتى ماركس يقول عن نفسه «كل ما أعرفه، هو أنني لست ماركسيا» وإلا كيف كان بإمكان المثقف اليساري أن يفهم نفسه، لكي يفهم تناقضات الواقع العربي؟
لقد فقد المثقف اليساري القدرة والإمكانية على تقديم رؤية جديدة للعالم، ليس لأن الماركسية تجمّدت عند حدود معينة من تطور قوانين حركة التاريخ، أو لأنها فشلت في تغيير العالم، وليس لأن «الشيوعية اليسارية ـ مرض طفولي» بعبارة لينين، وإنما لأن مشكلة المثقف اليساري تكمن في كيفية إنتاج متخيّل ثقافي جديد يتجاوز «قداسة الماركسية» ويتخطى الانبهار بنموذج الشيوعية بوعي جديد أيضا، أي: كيف يكون المثقف ماركسيا عابراً للماركسية، أو شيوعيا عابراً للشيوعية؟
ورغم جدل شخصية غورباتشوف السكرتير السابع والأخير في نهاية الشيوعية، فقد كان منتجا ً لأفكار يسارية جديدة بأخلاقيات ثقافية جديدة أيضا، فقد جمعت «البريسترويكا» التي تعني «إعادة البناء» بين تحليل الواقع ونقده وتحريره من الضوابط الصارمة لديكتاتورية البروليتاريا، حيث أقرّت بالديمقراطية أولا، ونبذت العنف الثوري المسلح، وجعلت من «هدف الصراع الطبقي هو السلام والانسجام» و»برّزت الدور التقدمي للدين» وقبل ذلك اعترفت بـ»أن فكر ماركس يحتاج للمراجعة» (ميشيل هيلير/ السكرتير السابع والأخير/ نشوء وانهيار الامبروطورية الشيوعية/ ترجمة نظير جاهل وحسن الضيقة/ شركة المطبوعات للنشر والتوزيع/ بيروت – لبنان 1996). وإن كانت «البريسترويكا» تمثل ثورة من الداخل لـ «إعادة البناء» فلماذا إنهارت الشيوعية؟ هل فقدت الشيوعية القدرة والإمكانية على استيعاب (منتج الأفكار) الجديدة؟ تلك هي طاقة الخطأ في تاريخ بناء الشيوعية.
لقد انهار اليسار الثقافي، بعد أن توقف عن إنتاج أي تفكير ثقافي جديد بحيوات جديدة، وذلك قبل انهيار الشيوعية في العالم.
كاتب من العراق
القدس العربي
—————————
في الواقع لا في النص: أيّ يسار، أين، وأية سياسات يسارية؟/ ياسين الحاج صالح
12 يوليو 2010
لا يسع نقاشا مثمرا في شأن هوية اليسار ودوره في العالم العربي اليوم أن يَغفل عن ثلاثة أشياء. الأول أن وراءنا تاريخا يساريا عريضا، محليا وعالميا، انتهت صيغته الأبرز إلى إخفاق فادح وإلى هزيمة أخلاقية لا شك فيها قبل نحو عقدين من السنين؛ والثاني هو أن كلا منا، عموم اليساريين العرب، ينطلق من موقع محدد، لا تكفي عبارة العالم العربي لتعريفه، بالنظر إلى تعدد الدول العربية وتطورها غير المتكافئ والاختلاف الكبير في حقولها السياسية والإيديولوجية، وفي المشكلات والتحديات التي تطرح عليها. وأخيرا عرفت البلدان العربية في سنوات ما بعد سقوط الشيوعية سياسات اجتماعية واقتصادية “ليبرالية”، تمخضت عن انتشار واسع للفقر والبطالة والتهميش، وعلى ظهور برجوازيات جديدة فائقة الثراء، دون مؤشرات على تطور تنموي متناسق في أي منها، أو على تحسن ولو محدود في مجال الحريات العامة وحكم القانون.
فإذا اصطلحنا أن المسألة اليسارية هي جملة الأسئلة والقضايا التي يثيرها وضع اليسار في بلداننا اليوم، فلا غنى لأية مقاربة نقدية للمسألة اليسارية من أن تكون مضاعفة، “نقدا مزدوجا”. من جهة للتجربة اليسارية السابقة، الشيوعية كعتاد إيديولوجي وفكري، كما كتشكلات تنظيمية وممارسات سياسية ووعي ذاتي؛ ومن جهة أخرى نقد للواقع المعاين في بلداننا وفي العالم. من شأن نقد يساري للواقع الحالي لا ينتقد الأدوات النقدية الموروثة أن يكون ماضويا، يطبق عتادا وحساسية قديمة على أوضاع متجددة لا تكف عن التغير. وبالعكس، من شأن الاكتفاء بنقد الشيوعية أو الصدور عن عدم كفاية أدواتها، دون النظر في وقائع اليوم وصراعات الحاضر، أن يفضي إلى الانجراف السلبي في تيار التحولات الجارية، التي تجمع بين الليبرالية الاقتصادية والتسلطية السياسية والتجزؤ الاجتماعي.
ستحاول هذه المقالة ممارسة نقد مزدوج للواقع وللإيديولوجية الشيوعية في الإطار السوري، من باب إكساب التحليل شيئا من العيانية. اليسار السوري ليس هو موضوع النقاش هنا، لكن سورية هي إطار الإحالة الواقعي للتقديرات الواردة فيه. وبينما يحاول التحليل أن يجمع بين ملاحظة الواقع والتحليل النظري، فإنه أيضا محصلة تفاعل شخصي مع مجال الوقائع المعنية وصيغة انخراط منحازة وواعية لانحيازها في الصراع السياسي والإيديولوجي الجاري اليوم في البلاد. لذلك أحيل تكرارا هنا على مقالات كتبتها في بضع السنوات السابقة.
في مجال الوقائع الأساسية
يفوت المقاربات الشائعة التي تنسب نفسها إلى اليسار في سورية اليوم تشكل نظام نخبوي جديد ثلاثي الأجنحة، مكون من نواة سياسية أمنية تستأثر بالسلطة العمومية، ومن برجوازية جديدة امتيازية تكونت في كنف السلطة المحتكرة، وجنت ثرواتها المهولة بآليات “تراكم أولي” ، ومن إيديولوجيين ومثقفين عضويين لهذا التشكل الجديد موزعين بدورهم على تيارين، تيار إسلامي مستأنس سياسيا ومحافظ اجتماعيا ومتشدد دينيا، وتيار علماني ليبرالي محافظ سياسيا ومتشدد إيديولوجيا. تدين القيادة بلا ريب للجناح الأول، النواة السياسية الأمنية، خلافا لما يفضل نقد يساري داجن، لا يرى غير “فريق اقتصادي” في الحكومة يصب عليه جام غضبه. يثابر هذا التيار على كلام شيوعي تقليدي عن الشأن الاقتصادي الاجتماعي، يدافع عن دور الدولة كمالك، ويندد بتحرير الاقتصاد وبالخصخصة، واضعا نمط إنتاج السلطة وممارستها خارج تحليله تماما. هذه شيوعية غير نقدية وقبل نقدية. معلوم فوق ذلك أنها فاقدة للاستقلال الفكري والسياسي.
بالمقابل، لا يطور اليسار غير الشيوعي أو الناقد للشيوعية، وهو شيوعي سابقا ومعارض سياسيا للنظام، مقاربات تحيط بالتحولات نفسها أو ترى التغيرات الجوهرية للبنية الاجتماعية في البلاد. يثابر المعارضون على تركيز انتقاداتهم على نمط ممارسة السلطة وحده، فتفوتهم التحولات الاقتصادية والتحالفات الاجتماعية الجديدة، وتحول الجمهورية إلى “دولة سلطانية محدثة”، والتجزؤ الاجتماعي المتفاقم.
لا مجال هنا لتوسع شاف في أصل هذه الثنائية. نشير سريعا إلى أن اليسار المستقل وجد نفسه منذ سبعينات القرن الماضي مسوقا إلى التركيز على مسألة الحريات الديمقراطية بالتوازي مع التفاقم الفاحش في الاستبداد السلطوي ومع تأزم وعقم ما كان يسميه ياسين الحافظ في حينه “الماركسية المسفيتة”. لبعض الوقت، بتأثير فاعلية الأصل اليساري وبفعل حضور الشيوعية كإيديولوجية وكمعسكر دولي، شكلت الفكرة الديمقراطية نقطة توازن بين منزع اشتراكي موجه نحو المساواة الاجتماعية، ومنزع سوف يوصف لاحقا بالليبرالي موجه نحو الحريات وتقييد السلطة. تُطلُّ الفكرة الديمقراطية تكوينيا على أفقين، أفق جمهوري وعامي واشتراكي، وأفق ليبرالي ودستوري وفرداني. تدافع عن سيادة الشعب والمساواة من جهة، وعن الحريات وحكم القانون وتوازن السلطات من جهة أخرى . بعد انهيار الشيوعية عالميا، وكان أكثر اليساريين السوريين المستقلين في السجن وقتها، تضاءل المكون الاشتراكي وتضخم المكون الليبرالي. عززت ذلك سيكولوجية المعتقل السياسي الذي عانى طويلا من الاضطهاد، فكان طبيعيا أن تشغل المسألة السياسية مركز اهتمامه. ساعد عليه أيضا انقطاع مديد، جاوز عقدين من الزمان، من النقاش والتفكير السياسي الحي الذي يقرب المبادئ النظرية من النشاط العملي، والمفكرين من المناضلين السياسيين. وفاقم ذلك كله فقر الفكر السياسي في سورية بتأثير خطورة السياسة أو الشحنة الكهربائية الشديدة السارية في كل ما هو سياسي في البلد طوال عقدي القرن العشرين الأخيرين. وثمة بالطبع مفاعيل مناخ فكري ليبرالي عالمي، من النوع الذي لطالما كان قوي التأثير على “الإنتلجنسيا” العربية، والسورية منها طبعا.
… حتى إذا هل القرن الجديد بانتقال السلطة في البلاد وفق الطريقة المعلومة، ثم بروز البرجوازية الجديدة الذي تكرس رسميا في مؤتمر حزب البعث صيف عام 2005، لم يكن لدى الطيف اليساري السوري شيئا مهماً يقوله. فلنثبِّت هنا هذه الواقعة اللافتة: لم يكد يقال شيء في سورية عن مصير كل من الجمهورية والاشتراكية . هذا يعطي فكرة عن محدودية الفروق الفعلية بين مختلف التيارات الإيديولوجية في البلاد.
السنوات الأخيرة تظهر بجلاء عدم كفاية المقاربتين، الديمقراطية الليبرالية والشيوعية التقليدية. الأولى مشدودة النظر إلى الاستبداد الحكومي، فلا تكاد ترى التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والثانية لا تكاد ترى مسألة السلطة، فتخفى عنها الصفة السياسية للاقتصاد في سورية (ولكل اقتصاد)، وفقا للمأثور الماركسي، أي ارتباطه بالطبقات والسيطرة الطبقية والسلطة السياسية. في المحصلة، لدينا نقد ليبرالي سياسوي، ونقد شيوعي اقتصادوي. وفي المحصلة أيضا نفتقر إلى رؤية وتحليل شاملين لأوضاع البلاد.
هذا يعيدنا إلى الحاجة إلى نقد مزدوج. نقد الواقع ونقد نقده الشيوعي الذي لم يعد مؤهلا على تطوير نقد شامل له. لكن كذلك نقد النقد الليبرالي الذي نعلم أنه ولد في وسط المعارضة السياسية اليسارية، وليس في وسط طبقة وسطى محلية، لم تكن موجودة إلا كمرتبة دخل.
في نقد الشيوعية
تمدُّ الاقتصادوية الشيوعية جذورها في مفهوم للاشتراكية متمركز حول المِلْكية، ساد حتى انهيار الشيوعية قبل عشرين عاما. إجرائيا، الاشتراكية هي تأميم وسائل الإنتاج أو تغيير ملكيتها لمصلحة الطبقة العاملة. وحيال هذا التقليص الإجرائي لم تُتِح “الماركسية اللينينية” التي فرضت عقيدة مقدسة فرصة للتساؤل عما إذا كانت الاشتراكية نظام ملكية مادية مساواتي، على ما كانت الحال في الاتحاد السوفييتي؛ أم هي ضرب من عدالة مالكين عامة، مادية وسياسية وثقافية، كما في الاشتراكيات الديمقراطية الغنية في شمال أوربا؛ أم أنها بالأحرى تملك اجتماعي عام للتغيير، بمعنى سيطرة عموم الناس على العمليات الاقتصادية والسياسية والمعرفية التي تشكل مجتمعاتهم وتحركها . من جهتنا، نتصور أن تملك التغيير أقرب إلى المثال الأعلى الاشتراكي. لا يكفي تغيير الملكية أو “نزع ملكية نازعي الملكية”؛ المطلوب الهيمنة الاجتماعية على التغيير، أو سيطرة المجتمع المستمرة على شروط حياته المتغيرة. لا يكفي الاشتراك في ملكية الموارد الاجتماعية، ينبغي كذلك تملك الدولة، أي مركب أجهزة التحكم السياسي الذي من شأن امتلاكه الخاص أن يولد لا مبالاة واغترابا معممين، وإن من وراء إيديولوجية مبالاة كاذبة على نحو ما كانت الشيوعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
لكن عدا تملك العمليات السياسية والعمليات الإنتاجية، يفترض لمفهوم تملك التغيير أن يحيل أيضا إلى السيطرة الاجتماعية على عمليات المعرفة وإنتاج المعلومات، أي كل ما يتصل بالاستيعاب المعرفي للحياة الاجتماعية. هذا يصطدم فورا مع تصور أن المعرفة الصحيحة مذخورة في مذهب بعينه أو في فكر متفوق على غيره لكونه يحتكر وحده صفة العلمية. ليس من المثال الاشتراكي في شيء أن تحصر الحقيقة في جسم محدد من المعارف يسوغ لمالكيه أن يحوزوا سلطة على غيرهم بفضل امتلاكهم له.
هناك صلة عميقة فيما نرى بين تصور الاشتراكية كنظام ملكية، وبين كل من خصخصة الدولة وامتلاكها حزبيا، وخصخصة الحقيقة وامتلاكها مذهبيا، صلة تمثل في التمركز حول الملكية. فإذا كان المثال الاشتراكي الذي يكثفه تعبير تملك التغيير هو ما يعرِّف اليسار، فإنه يتعين تمييز اليسار بكثرة من الممارسات النقدية والاحتجاجية والانشقاقية، ومن صيغ التعاون والتنظيم، لا بمذهب كلي تتمركز الحقيقة فيه، أو بتنظيم واحد قد يسمى شيوعيا أو لينينا. كثرة الممارسات تلك قد تتقارب وتتقاطع، لكنها لا تشكل معسكرا أو حزبا واحدا. وكما الاشتراكية ليست نظام ملكية، ليس اليسار حزبا سياسيا، ولا التوجه اليساري مذهبا أو إيديولوجية بعينها. إن تملك التغيير فعل مقاومة وكفاح، وليس نظاما قانونيا أو جهازا سياسيا أو “نمط إنتاج” اقتصادي.
نقد المذهبية الماركسية والشيوعية أساسي من وجهة نظر إعادة التفكير في مفهوم اليسار وهويته. موقفنا متهافت حين ننتقد الدور القيادي الذي يمنحه حزبٌ لنفسه تحكميا، ونسكت على الدور القيادي لنظرية معينة أو جسم محدد من المعارف في تشكيل وعينا والوعي العام. يسع السلطة المرجعية أن تكون مستبدة مثل السلطة السياسية أو أكثر استبدادا. فإذا زالت السلطة السياسية الاستبدادية وظل دستور السلطة المرجعية دون تغيير بقي مفتوحا باب التطلع إلى حكم استبدادي جديد.
على أن نقد المذهبية الفعال ليس ذاك الذي يُنوِّه بالانفتاح الفكري والروح النقدية، بل الذي يقابل المذهب بالروح المتوثبة، بانفعال مختلف وأكثر إقبالا على الحياة، بحساسية مغايرة، مُحِبّة وشجاعة. اليسار حساسية ونشاط وروح فتية وانفتاح على فوضى الحياة وتدفقها المتجدد دوما، وليس أفكارا ومواقف فقط، ولا هو نضال وعمل فقط.
في هذا أيضا لا نسجل فروقا ذات قيمة بين التيارات الإيديولوجية السورية المتحدرة من الجذع الشيوعي. القليل الموجود منها ليس في صالح الشيوعيين.
من هذا المنظور ليست الماركسية هي الشيء المهم بل الكفاح اليساري. ندافع عن فصل اليسار عن الماركسية أو فك الارتباط بينهما. اليسار عمل مفتوح، والماركسية مذهب أو نظام مغلق. يستطيع ماركسيون أو منسوبون إلى الماركسية أن يقولوا إن الماركسية مفتوحة، وأن بتصرفها منهجا يضمن انفتاحها الدائم اسمه “الجدل المادي”. غير أن هذا تقرير تحكمي لا سند عقليا أو تاريخيا له. بمجرد نسبة توجه فكري إلى أصل مشخص، ماركس، نكون أقمنا مذهبا وعقيدة، بنينا سياجا وأغلقنا أفقا مفتوحا.
لكن في الوضع العياني لثقافتنا والتفكير النقدي فيها، الوضع المتسم بضعف التيارات النقدية والتحررية، نجد في الاتجاهات الأكثر نقدية من التفكير الماركسي سندا واقعيا لتنشيط التفكير والحساسية والكفاح اليساري في الإطار العربي. العلاقة هنا علاقة تحالف وملاءمة جائزة، وليست علاقة مفهومية ضرورية منطقيا، تقضي بألا يكون اليسار إلا ماركسيا. يعزز فرص العلاقة الجائزة تلك وجود تراث كفاح ماركسي فعلي، سوريا وعربيا.
لكن ينبغي أن يفهم هذا الاستدراك على نحو ما يفهم دفاع اليساريين عن دور أوسع للدولة في الاقتصاد اليوم رغم تحفظهم المبدئي عنها وتطلعهم إلى زوالها. في الظروف العيانية المعاصرة يمكن للدولة أن تحمي القطاعات الأضعف اجتماعيا من الفعل المفقر والمهمش لآليات السوق العمياء. لا يعني هذا بحال أن اليسار دولتي مفهوميا وحتما.
نضيف أيضا أن الماركسية التي يمكن أن تكون سندا لنشاط يساري هي التحليل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الماركسي، وليس بحال “الفلسفة الماركسية” و”الجدل المادي”.
في نقد ليبراليتنا
ألمحنا فوق إلى أن الليبرالية ولدت في سورية في أوساط اليسار الشيوعي، المكون من مثقفين، لا في بيئة الطبقات والقوى الاجتماعية. هذا لكون الاشتراكية البعثية قلصت، لحين، الفوارق الطبقية المادية وعزلت كل الأحيان ما يحتمل أنه بقي منها عن السياسة والفضاء العام (المغلق والمحتكر)، فكان أن حلت محلها التمايزات السياسية والفوارق الإيديولوجية على نحو ما كان جرى في المعسكر الشيوعي أيضا؛ وكذلك لأن الطيف اليساري الشيوعي كان طوال ستينات القرن العشرين وسبعيناته، وربما بعضا من ثمانيناته مهيمنا ثقافيا، وعنوانا للحداثة الفكرية والثقافية، انضوى تحت لوائه حشد متنوع يتوزع اليوم على كامل الطيف الإيديولوجي، بما في ذلك نزعات نخبوية يمينية وأرستقراطية معادية للعامة، وبما فيها نزعات إسلامية وقومية متشددة، وبما فيها الغربوية والأميركانية الأكثر تطرفا، وبما فيها الستالينية وتناسخاتها.
بيد أن مفهوم الليبرالية قلما استخدم حتى سنوات خلت. فيما عدا اهتمام ياسين الحافظ في أواسط سبعينات القرن العشرين بـ”اللحظة الليبرالية” المفقودة في التطور السياسي والاجتماعي الاقتصادي العربي ، بقى مدرك الليبرالية خارج التفكير اليساري. لكن في وقت متأخر من الثمانينات عرّف إلياس مرقص الديمقراطية بأنها الليبرالية + مفهوم الشعب. يصعب القول مع ذلك أنه برز مثقفون ليبراليون أو تيار ليبرالي حقيقي في سورية في أي وقت. كانت ليبراليتنا “موضوعية” ، مبطنة في المطالب الديمقراطية.
غير أن انهيار الاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي أدخل اليسار الشيوعي المستقل في أزمة فكرية عميقة، ما كان لها إلا أن تتفاقم بفعل كون أكثر المعنيين وقتها في السجون. لقد حصلت تغيرات كبرى دون أن يجري تفاعل فكري معها، بما كان من شأنه أن يوفر قدرا من تغطية فكرية وثقافية لها.
وعلى خلفية الأزمة المركبة هذه ينبغي أن يكون مفهوما جدا أن أول فرصة تماثل للعمل العام تسنت للسوريين (“ربيع دمشق” 2000- 2001) وعت نفسها بصورة أساسية بمفردات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة. جسدت “المنتديات”، وقد كانت خلاصة “ربيع دمشق”، التقاء حاجتين أساسيتين: حرية الكلام وحرية التجمع، أي ما يضع مجتمعا ما على “خط الفقر السياسي” . إن لم يكن الإفقار السياسي الجائر الذي تعرض له المجتمع السوري أولى بالمعالجة من إفقاره المادي، ما كان للإفقار الأخير أن يبلغ حدوده الحالية لو كان السوريون أقل فقرا سياسيا. وعلى كل حال لا مجال لمقاومة هذا في ظل العيش “على الحديدة” سياسيا. علما أن الجوع للسياسة قد يحفز الطائفية بوصفها هي سياسة الحديدة أو صيغة استحواذ مرواغة على السياسة المحرمة .
في المحصلة يخطئ كثيرا جدا من يرى في مدركات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة عناوين لسياسة أو تيار ليبرالي واع بذاته، أو من يأخذ على المثقفين والناشطين السوريين أنهم لا يحيطون بأصول وأدوار مفهوم المجتمع المدني ، ولا يتبين الوظيفة الديمقراطية والتحررية لهذه المدركات في الاستحواذ على السياسة وتوسيع المساحة السياسية الضيقة في البلاد، وبالطبع دورها في النقد السياسي.
ولذو دلالة أنه لم تبرز وقت “ربيع دمشق” لغات أخرى أبدا. ولم يستعد أحد اللغة الشيوعية. ويبدو لي أنها لم تستعد لاحقا، عام 2007 وما بعده بخاصة، إلا من باب التمايز ضمن الطيف المعارض ثم أكثر عنه، أي لإشباع مطلب الهوية الخاصة ، وليس لتحليل الواقع وبلورة سياسات ملائمة فيه. لم يطور منسوبو الشيوعية والماركسية أية تحليلات شاملة لتطور المجتمع والدولة والاقتصاد، والرأسمالية، في سورية. أبدا.
بفعل الإفقار السياسي الحاد الذي كان المجتمع السوري ضحيته، حازت المقاربات الديمقراطية المتمحورة حول مفهوم الاستبداد والمطالب الديمقراطية الخاصة بالحريات وحكم القانون قيمة تحررية منذ أواسط سبعينات القرن الماضي لم تحزها أية مقاربات أخرى. لكن البيئة السياسية والاجتماعية الاقتصادية السورية تتغير اليوم بتسارع، يُلزِم بإصلاح التفكير والسياسة الديمقراطية. كان الفراغ الفكري وقوة العطالة قد ساقا الفكرة الديمقراطية نحو صيغ حقوقوية وسياسوية ليبرالية في أوساطٍ حبسها تعطل التمايزات الطبقية في إطار إنتلجنسي أساسا، مفصول عن القوى الاجتماعية الجديدة بحواجز العزل السياسي والأمني والجيلي .
الشيء الذي لا يكفي تبينه اليوم، بل ويتعين إعادة بناء السياسة الديمقراطية عليه، هو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، المترتبة بخاصة على لبرلة الاقتصاد وهيمنة البرجوازيين الجدد، وظهور تنويعة من الليبرالية التسلطية النخبوية جدا واليمينية جدا والمقربة من السلطات جدا، ولا تبالي بالمبادئ الليبرالية من حريات ودستور وتقييد السلطة. هذا يُلزِم بإفساح مجال أوسع في تصور الديمقراطية لبعده الاشتراكي الذي كان سقوط الاشتراكية السوفييتية قد أتى عليه. مع ارتفاع معدل الفقر والهامشية والبطالة، مما هو معاين يوميا، ومما هو من المترتبات المعتادة على تحرير الاقتصاد، تغدو المقاربة الديمقراطية الموروثة أحادية الجانب أو ليبرالية محضا إن هي لم تتسع لاستيعاب هذه التطورات. يتحتم أن نتجه اليوم في اتجاه معاكس للذي سرنا عليه قبل نحو 35 عاما.
وإنما في هذا الاتجاه يمكن إعادة بناء الطرح اليساري. وعلى أرضية معلومات ومعطيات موثوقة لا يصعب توفرها اليوم بفضل وسائل الاتصال الجديدة. معرفيا، اليسار حليف الوقائع والمعلومات الكثيرة، وليس المضاربات الإيديولوجية العريضة.
وفي هذا الاتجاه فقط قد يمكن بناء تحليل شامل للواقع تمييزا عن تحليلات جزئية تعزل الاقتصاد عن السياسية والدين عن الدولة والخارج عن الداخل، فلا تتشكل حول كل منها غير إيديولوجيات جزئية تسهم في تعميم التجزؤ الاجتماعي والثقافي المتنامي في المجتمع السوري اليوم. يسار الأمر الواقع ليس غير مؤهل للاعتراض على التجزؤ السائر بل هو مندرج فيه بكل راحة بال، يخوض من موقعه الصغير معركة ليست له ضد أشباهه، ما من شأنه إدخال البهجة على قلوب الممسكين بأزمة السلطة والثروة في البلد.
خلاصة وآفاق
ماذا يمكن أن يستخلص من هذا التحليل المجمل؟ قبل كل شيء إن مواقع وأدوار أي فاعلين عامين محتملين تتحدد ضمن حقل سياسي ملموس وفي إطار استقطابات وصراعات واقعية. ليست كل المواقع ضمن هذا الحقل تتيح إحاطة أوسع وأشمل وبالمشكلات الاجتماعية والوطنية، ولا يتحدد موقع اليسار ضمنه بهوية محددة إيديولوجيا، بل بموقعه الفعلي وممارساته الفعلية في خريطة الصراعات الجارية. و”القوانين العامة” لتطور الحقل السياسي في سورية يحددها الموقع الهائل الذي يشغله نظام الحكم ضمنه. هذا يتسبب في إشغال قضايا الحريات العامة وحكم القانون مكانة كبيرة. لكن في السنوات الأخيرة وتحت تأثير لبرلة الاقتصاد تظهر أشكال من السلطة الطبقية مندمجة مع سلطة الدولة، بما يُلزِم بإعادة بناء السياسية اليسارية حول هذا التحول. هذا يوجب انشغالا أوسع بـ”المسألة الاجتماعية”، وإحياء المكون الاشتراكي في الفكرة الديمقراطية.
وضمن الحقل السياسي السوري لدينا استقطابان آخران يزيدان التحليل تعقيدا. استقطاب أول حول جملة القضايا والصراعات المتصلة بالمسألة الفلسطينية والمشكلة الإسرائيلية والهيمنة الأميركية، جملة ما كان يسمى قبل حين “المسألة القومية”؛ واستقطاب ثان حول الصراعات والتوترات المتصلة بالدين وعلاقاته بالدولة والقانون والتعليم والثقافة، أي المسألة الدينية.
فإذا كانت النواة الدلالية الأساسية لمفهوم اليسار تحيل على “المسألة لاجتماعية”، فماذا يحتمل أن يكون حال الهوية والدور اليساريين في حقل سياسي تحضر فيه ثلاثة مسائل كبرى إضافية؟ وهل من معادلة ذهبية يمكن بلورتها لربط المسائل الاجتماعية والسياسية والقومية والدينية بحيث يكون الكائن اليساري في أحسن تقويم؟
هذا غير ميسور فيما نرى. اليسار يكون أصلح ما يمكن حين نكون في “وضعية يسارية”، تشغل المسألة الاجتماعية مركز ثقل العمل العام أو تتصدر أجندته. حين تكون ثُلث المشكلات أو رُبعها يتأثر وضوح الفاعلية اليسارية ويتراجع النجوع التحليلي والسياسي لثنائية يسار ويمين. وبينما لا يستطيع أي يساريين محتملين أن ينأوا بأنفسهم عن مشكلات عامة أيا تكن بذريعة اختصاصهم بالمسألة الاجتماعية، فإنه ليس من الحظ الطيب لليساريين حضور مشكلات أخرى، لا بد أن تتحكم بوجهة ومضمون يساريتهم والحيز الذي يشغلونه في الحياة العامة في بلدانهم والمحصول المحتمل لعملهم. لا يكفي القول إن اليسار ديمقراطي حتما، وقومي حتما، وعلماني حتما، فوق كونه اشتراكيا طبعا. في النشاط العملي في بلداننا، يحصل أن تتعارض مقتضيات الاشتراكية مع مقتضيات الديمقراطية، وموجبات هذه مع موجبات العلمانية، وموجبات العلمانية مع اعتبارات وطنية أو “قومية” قد تضع اليساريين المفترضين في موقع قريبة من مواقع إسلاميين. هنا أيضا ليس ثمة مفتاح ذهبي لسياسة يسارية متسقة حيال هذه المشكلات معا.
ما نستخلصه من ذلك أن السياسة اليسارية سياسة مثل غيرها، لا تتوفر على ضمانات أكثر من غيرها لأن تكون السياسة الأنجع. ومن الانتهازية المميزة لأصحاب العقائد جميعا أن تمارس السياسة وراء ظهر العقيدة، وأن ترفع العقيدة فوق رأس السياسة.
وفي هذا الشأن نرى أن فرصة سياسات أقل تخبطا وانتهازية ربما تكون أكبر بقدر ما تكون الثقافة ناهضة مزدهرة. الثقافة مجال عام، وأحد أسس قيام إجماعات عامة تحد من الميل الانقسامي الكامن في كل المجتمعات، والناشط في مجتمعاتنا هذه الأيام. في غيابها، اليسار معرّض لأن يكون إيديولوجية فقيرة، مثل غيرها أو أفقر. قول ذلك ضروري لأننا نلحظ انبعاث عادة يسارية سيئة بقدر ما هي عريقة، تشبه كثيرا عقيدة “الولاء والبراء” السلفية، وتقضي بأن أي يساري أقرب إليّ مهما يكن غثا رثا من غير اليساري، ولو كان محمود درويش أو نجيب محفوظ.
هذا عمى وعصبوية.
وبمناسبته نتساءل عما إذا لم يكن لدينا مشكلة ثقافية تضاف إلى المشكلات الاجتماعية والسياسية والقومية والدينية.
ختاما، يبدو أن هناك اليوم موجة تعاف عالمية لليسار، تتمثل في ازدهار التفكير النقدي المنخرط اجتماعيا والأنشطة الاحتجاجية، والعود إلى مساءلة الرأسمالية. قد لا تتيح لنا نوعية مشكلاتنا العامة المعاصرة المرغوبة لهذه الموجة، إلا أننا نكون معاصرين لمشكلاتنا بقدر ما نحرص على الروح النقدية والانخراط في صراعات اليوم في مجتمعاتنا، ونتجنب بخاصة الدخول في الأزقة المسدودة للمعتقدية والحزبية الضيقة.
*****
1- تنظر مقالتي: في أصول نظام الاستثناء السوري: محاولة ماركسية، جريدة “الحياة”، 9/3/2008.
2- مستندا إلى التراث السياسي لبلاده، يميز الفيلسوف الأميركي ريتشارد رورتي بين مفهوم دستوري للديمقراطية ومفهوم مساواتي لها، هي في الحالة الأولى نظام حكم، تكون السلطة فيه بيد مسؤولين تم انتخابهم بحرية، بينما تشير في الحالة الثانية إلى مثال اجتماعي ضامن للمساواة في الفرص وموجه ضد التمييز الاجتماعي. مقالته: الديمقراطية والفلسفة، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 151-151، ربيع 2010. والمقالة أصلا محاضرة ألقيت في طهران في نيسان 2004. تنظر أيضا مقالتي: وجهان اشتراكي وليبرالي للنقد الديمقراطي، “الحياة”، 13/1/2008.
3- الواقع أن برهان غليون تكلم في كتاب حواري عن وضع الفكرة الاشتراكية العام وعن صلتها الوثيقة بالديمقراطية، لكن ليس في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية سورية كانت وقتها غير ملحوظة، ولا في سياق تناول سياسة نخبة الحكم ووضع إيديولوجيتها وهياكلها السياسية. الخيار الديمقراطي في سورية، إعداد وحوار لؤي حسين، الطبعة الأولى، دار بترا، دمشق، 2003. بخاصة ص ص 9- 37. عدا ذلك لا شيء تقريبا.
4- سبق أن ميزت في هذا المنبر بين تغيير الملكية وتملك التعيير. الآداب، العدد 1/2، 2005. ملف الشيوعية العربية بين الواقع والمرتجى.
5- من مقدمة عبد الإله بلقزيز لـ الأعمال الكاملة لياسين الحافظ، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005؛ ص 30.
6- الواقع أنه ظهرت بعد عام 2003 مجموعات نسبت نفسها إلى الليبرالية، لكنها ليست من الجذع اليساري القديم، وتشترك في أنها قريبة سياسيا إلى النظام وبرجوازيته الجديدة، وأنها تلاشت بالطريقة الغامضة ذاتها التي ظهرت بها. تراجع مقالتي: “بين ليبراليتين في سوريا: “ليبرالية موضوعية” بلا وعي ذاتي، و”ليبرالية ذاتية” بلا شروط موضوعية”. متاحة على الرابط:
http://www.yalhajsaleh.com/2009/12/blog-post_8670.html
7- تراجع مقالتي: في مفهوم خط الفقر السياسي، الحياة، 15/12/2004.
8- في دراسة رعتها الأمم المتحدة عام 2004 تبين أن نسبة من يعيشون دون خطر الفقر الأدنى (أقل من دولار أميركي واحد في اليوم) تقارب 11,4% من السكان، ومن يعيشون دون خط الفقر الأعلى (دولارين يوميا) حول 30%. ينظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الفقر في سورية 1996-2004، حزيران 2005. الأرقام اليوم أعلى بلا ريب. عدد السكان اليوم نحو 23 مليونا
9- مقالتي: الطائفية كحصيلة للفقر السياسي وكحد له. “الحياة”، 28/12/2008.
10- على ما استطاع عزمي بشارة قوله في التلفزيون السوري عام 2001، وكذلك عزيز العظمة وفيصل دراج في مقالة لهما في جريدة “الحياة” في 29/6/ 2001.
11- لا ريب أن لأزمة المعارضة السورية، متمثلة بائتلاف “إعلان دمشق”، دور في عودة اللغة والرمزيات الشيوعية. ولعل التكوين الشيوعي التقليدي المعادي للغرب يستفيد كذلك من انتعاش ثقافة الممانعة ومناخاتها في البلاد في السنوات الأخيرة. لكن يبقى أن من الممتنع في تقديري خروج الشيوعية من وضع “العصبة” المغلقة إلى وضع الطرف المبادر والقادر على بلورة سياسات عامة على المستوى الوطني.
12- أتجنب عامدا التعيين لاعتبارات ذات صلة بالتكوين المستقطب بشدة راهنا للحقل السياسي والإيديولوجي السوري. وبأمل أن أتمكن يوما من إنجاز بحث مفصل عن مسارات الطيف اليساري السوري خلال العشرية الماضية.
خاص – صفحات سورية –
———————————
مفهوم لخط الفقر السياسي/ ياسين الحاج صالح
على غرار مفهوم خط الفقر المستخدم في الدراسات التنموية يمكن أن نفكر في مفهوم لخط الفقر السياسي، قد يفيد في تصنيف الدول سياسيا. ونقترح أن الشعوب التي تقع دون خط الفقر السياسي هي الشعوب المحرومة من حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتنظيم.
لماذا هاتان الحريتان بالذات؟ لأنهما حاجتان حيويتان قبل أن يكونا مطلبين كماليين متصلان بمفهوم حديث للديمقراطية أو لحقوق الإنسان. فضرورة حرية الراي مبنية على حاجة الناس إلى التعبير عن حالهم وإعلان شكاويهم والقول إنهم متألمون أو جياع أو محاصرون. إنها أساسا “حق” في الصراخ من الألم. ولا منافس لحرية التعبير في تعرف المجتمعات الحديثةعلى مشكلاتها وفي تحويل المشكلات إلى مسائل برسم الحل (المسألة طرح معلن وصياغة عقلانية ومنظمة للمشكلة). وبدورها حرية التجمع حاجة حيوية تتصل بلزوم التعاون لتحقيق مصالح جمعية والتضامن في الشدائد والدفاع الجمعي عن الذات. ولعل التجمع في الأصل والأساس احتشاد لدفع خطر داهم.
والصراخ ألماً والاحتشاد الدفاعي أساسيان أو غريزيان بقدر ما الغذاء واللباس والسكن كذلك. وهما بهذه الصفة يصلحان لتعريف خط الفقر. فهل هناك إدقاع أشد مما يعانيه مجتمع ممنوع من الصراخ والإلتئام؟
وفيما وراء الحقوق والغرائز حريتا التعبير والتجمع وظيفتان اجتماعيتان لا تتكامل المجتمعات الحديثة و”تشتغل” من دونهما.
ليس هناك تطابق أو ارتباط مباشر بين خط الفقر الخاص بالدراسات التنموية وخط الفقر السياسي. فمن الممكن أن يكون بلد فقيرا وديمقراطيا، وربما نجد بلدانا ثرية (ثروة ريعية بخاصة) ومملقة سياسيا، وتجمع معظم بلادنا العربية الأسوئين فيما تجمع الديمقراطيات الغربية بين الأحسنين. وربما تكون العلاقة عكسية بين الفقرين: فالمجتمعات الفقيرة سياسيا تنحو إلى أن تفشل ماديا وإلى اتساع دائرة الفقراء المطلقين فيها.
يتميز نظام الفقر السياسي بفجوة واسعة في توزع السلطة السياسية في المجتمع قد تفوق فجوة توزع الدخل. كانت مجتمعات أوربا الشرقية بالغة الفقر سياسيا رغم أنها متوسطة الدخل على العموم. وكانت تحكمها نخب نخب فاحشة الغنى السياسي تفعل ما تشاء. وكان الألمان الشرقيون اغنى ماديا من الإيطاليين لكنهم أفقر سياسيا بكثير منهم. ورغم ان متوسط الدخل السنوي للفرد السوري أعلى من دخل الفرد اليمني فإن سوريا أفقر من اليمن ومن معظم الدول العربية سياسيا. ويتمتع الأردنيون واللبنانيون من الدول العربية المجاورة بحريتي التجمع والتعبير عن الراي بدرجة لا تتوفر للسوريين. أما فلسطين والعراق فأوضاعهما أعقد من ان تجدي المقارنة مع سوريا. فهما بلدان يقبعان دون “خط فقر سيادي” مدقع إن جاز التعبير. ثم إن المشكلات اللبنانية، سواء ذات بعد السيادي أو تلك المتصلة بحرية التعبير والتجمع، متصلة بتعميم “نمط الإنتاج السياسي” السوري بدرجة كبيرة.
وتتنوع الصيغ التنظيمة لبلاد الفقر السياسي، فمنها دكتاتوريات فردية، ومنها أنظمة حزب واحد، أو أنظمة لا تسمح أصلا بوجود أحزاب سياسية أو اي شكل من اشكال الانتظام الاجتماعي المستقل. وقد تكون عقائدها دينية او علمانية. وقد تكون اقتصادياتها دولانية و”مخططة”، لكنها قد تكون أيضا اقتصاديات سوق. والشعوب الأفقر سياسا هي التي تحكمها أنظمة الطغيان المحدث التي سميت الأنظمة الشمولية.
كان أمارتيا سن قد غير مفهوم التنمية حين عرفها بأنها توسيع للخيارات، أو ببساطة: حرية. وفي كتابه “التنمية حرية” يؤكد أنه ما من بلد ديمقراطي واجه مجاعة خطيرة، رغم انه حصل لديمقراطيات متوسطة ومتدنية الدخل أن واجهت كوارث طبيعية واوضاعا اقتصادية صعبة. وبالعكس: “إن البلدين الذين يقودان تحالف المجاعة في العالم هما كوريا الشمالية والسودان، وكلاهما مثال ناصع للحكم الدكتاتوري”، حسب الاقتصادي الهندي الشهير. والمهم أن سن فتح الباب لتحرير المطلب الديمقراطي من ربطه بعتبة دخل دنيا (6000 دولار للفرد سنويا) كان يصر عليها كل من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والدول الكبرى، بما فيها الديمقراطيات الغربية طوال فترة الحرب الباردة. إنها نظرية “النمو أولا، الديمقراطية فيما بعد” حسب تعبير كل من جوزف سيغل ومايكل ولشتاين ومورتون هالبرين في دراسة مشتركة لهم بعنوان “لم تتفوق الديمقراطية على غيرها؟” ( مجلة فورين أفيرز الأميركية، أيلول/ تشرين الأول 2004).
ومشكلة الربط بين الديمقراطية والدخل المتوسط الذي تمثله عتبة الستة آلاف دولار أن أي نظام تسلطي لم يستطع أن يقود بلده إلى هذا المستوى من الدخل كما يقول الكتاب الثلاث المشار إليهم. اي ان فرص هذه البلدان في “الإقلاع الديمقراطي” ضعيفة جدا. وهو ما يثير الشك في صواب هذا النهج التطوري الذي يذكر بارتباط الاشتراكية بتقدم قوى الانتاج في المنظور الماركسي.
في بلدان الريع الاستخراجي العربية تطرح مشكلة مختلفة بعض الشيء لكنها تصلح مثالا على الترابط العكسي: انعدام الديمقراطية او ما سميناه الفقر السياسي يهدر الغنى المادي ذاته.
وكان تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعامي 2002 قد اعتمد مفهوم التنمية كحرية، ما قاده إلى تشخيص ثلاث فجوات غير اقتصادية تشكو منها التنمية العربية: فجوة المعرفة وفجوة الحرية وفجوة تمكين المرأة (صدر تقرير يغطي فجوة المعرفة في مطلع خريف 2003، ويوشك أن ينتهي عام 2004 ولما يصدر التقرير الذي يفترض ان يتدارس فجوة الحرية؛ عسى الا تكون الفجوة ابتلعته!)
يمكننا ما سبق من قول كلمتين حول فلسفة التنمية المعتمدة في سوريا، وهي فلسفة اقتصادوية مهتمة بمفهوم جامد وعقيم وأحادي البعد للتنمية، مفهوم يتردد حتى في الوعد برفع معدل النمو الاقتصادي وخفض جدي للبطالة، وفوق ذلك لا يطرح اية مطالب تخص العدالة والحرية.
ففي ظل الإفقار السياسي، وبالخصوص في عقد الثمانينات الضائع تنمويا وسياسيا وإنسانيا، أخذت تتسع دائرة الفقر وشرع القطاع الحكومي من الاقتصاد يراكم تخلفا متعدد المستويات. ولفرط جموده صار في النهاية اقتصادا طاردا حتى للاستثمار الحكومي. فمخصصات الاستثمار من الميزانية تفيض، وما ينفق منها مجادل في وجوه إنفاقه. وهذا وحده يكفي للقول إن الطرح الاستثماري لأزمة الاقتصاد السوري، أي باولوية الحصول على رساميل اجنبية، مغرض وغير صحيح. وإذا كانت سوريا هي الأسوأ بين بين 15 بلدا عربيا رئيسيا في مناخ الاستثمار حسب التقرير عام 2003 (ص 102)، فالفضل الأول في ذلك للفقر والقنانة السياسية.
وبينما قد يبلغ معدل البطالة ربع أو حتى ثلث قوة العمل في البلاد، فإن معدل البطالة السياسية ينافس النسبة الاستفتائية التسعة وتسعينية. وربما تكون الفائدة الوحيدة لهذه النسبة الأخيرة أنها مقياس دقيق لمؤشر البطالة أو السياسية.
فرص الإصلاح في سوريا مرهونة بالانفتاح على مفهوم التنمية الإنسانية، اي النظر للفقر والبطالة كمساس بالمواطنة والحرية. أما الفلسفة الحالية التي ترى في الحريات خطرا على التنمية فهي خطر على التنمية والحرية والمستقبل معا.
البداية الصحيحة معالجة الفقر السياسي. فدون رقابة ديمقراطية من السوريين على الانتقال الاقتصادي ستكون حصيلته انتقالا من فشل الدولة إلى فشل السوق حسب عبارة تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002.
————————————-
في أصول نظام الاستثناء السوري: محاولة ماركسية/ ياسين الحاج صالح
تواجه حالة الاستثناء في سورية التي حلت يوم أمس (8 آذار/مارس) ذكراها الخامسة والأربعون بضربين من الانتقادات. في المقام الأول يأخذ عليها حقوقيون تغطية إلغاء حياة قانونية سوية وتحكيم أجهزة أمنية تميل غريزيا إلى رؤية العالم كمنبع أخطار في الحياة السياسية للبلاد. وفي مقام آخر يأخذ معارضون سياسيون على حالة الطوارئ المقيمة تلك أنها لم تثبت نجاعتها في أي يوم في الرد على العدوانية الإسرائيلية، أو في تأهيل البلاد لطوارئ البيئة الإقليمية ومخاطرها على الأمن الوطني.
الانتقادان صحيحان، ويسهل إثباتهما بعدد وفير من الأمثلة. بيد أن ذلك لا يقول شيئا عن تفضيل السلطات دوام حالة الاستثناء. وحتى القول إن تعليق القوانين العادية وفرض شروط استثنائية يتيح عسكرة الحياة العامة في البلاد وتوفر البيئة الأمثل، سياسيا وإيديولوجيا ونفسيا، لاحتكار السلطة، وهو قول صحيح بدوره، لا يستنفد في نظرنا شرح الحرص البالغ من قبل السلطات على أحكام الاستثناء وقوانينه وإيديولوجيته وأجهزته الضاربة، أي نظام الاستثناء. ثمة عنصر آخر قلما يتنبه إليه نقاد النظام، يتمثل في أن النظام هذا هو الأنسب لإدامة ما يسمى في التحليل الماركسي «التراكم الأولي»، أي جمع ثروات كبرى بوسائل تجمع بين القسر والاستيلاء والإكراه والأساليب غير المشروعة. فليس أنسب من تعليق القوانين والأعراف المستقرة لتسهيل أمر عمليات إثراء مهولة، لا تصلح عبارات من نوع «كسب غير مشروع» و»فساد» للإحاطة بها. وليس أنسب حجابا للعمليات نفسها من الإيديولوجية الوطنية التي لا تسير حالة الطوارئ دون جرعات عالية على الدوام منها. وإذا كانت حملات مكافحة الفساد والكسب غير المشروع تفشل نسقيا فلأنها لا تمس أبدا الأساس الذي يرعى موازين القوى الاجتماعية المناسبة لها، نظام الاستثناء نفسه. فليس «الفساد» انتهاكا لقواعد عمل النظام الذي يقيد قدرة المجتمع على المطالبة والاحتجاج ويمنع الطبقات الأضعف من التنظيم والتضامن دفاعا عن نفسها، بل هو ابنه الشرعي وثمرته الطبيعية. وهو ما يحكم بالتهافت على كل كلام على «مكافحة الفساد» لا يندرج في سياق العمل على إلغاء حالة الاستثناء.
ولا نجد تفسيرا أفضل لواقعة أن نظام الاستثناء لا يلتزم بقوانينه ذاتها، حتى لو سنها لتوه، من أن التراكم الأولي يقوم على القوة العارية أو الخام الممتنعة على أي انضباط، والمتعارضة ماهوياً مع فكرة القانون ومبدئه. ولعله ما من تعبير يتكثف فيها منطق التراكم الأولي أفضل من كلمة «سلبطة» الدارجة في سورية، والتي تلتقي فيها مدركات السلب والتسلط واللبط.
في مرجعه الماركسي يحاول مفهوم التراكم الأولي الإجابة عن سؤال عن المصدر الأول لرأسمال الرأسماليين. قال ماركس إنه النهب والسلب والقرصنة والاستعمار… لكن رأسمالية القرن التاسع عشر التي حللها المفكر الألماني في «الرأسمال» كانت تجاوزت طور التراكم الأولي، وأخذ سليلو القراصنة يشكلون طبقة اجتماعية مستقلة تعتمد في تعظيم ثرواتها على الربح المجني من استغلال الطبقة العاملة.
والحال، قد تكون الحصيلة الصافية لحالة الاستثناء السورية تشكل طبقة من رأسماليي السلطة حلت محل طبقة الأعيان القديمة المكونة من ملاك أراض كبار ومن تجار وصناعيين، والمتحكمة في السلطة السياسية. لكن ما من مؤشر في الأفق على أن البورجوازية الجديدة هذه، التي تزداد ظهورا في السنوات الأخيرة التالية للانسحاب السوري من لبنان، في وارد الاستغناء عن نظام الاستثناء، الأمر الذي يحيل إلى ضعف تشكلها الاجتماعي والسياسي، وعجزها عن التحول إلى طبقة رأسماليين مستقلة. وإنما لذلك على الأرجح تمزج التشكيلة السورية الراهنة بين نظام اقتصادي يزداد انفتاحا ونظام سياسي محافظ على تسلطيته واستثنائيته. ولعله لذلك أيضا تعرض لبرلة الاقتصاد البازغة ملامح احتكارية منذ الآن، وتكاد تقتصر على تنامي وزن المشاريع الخاصة في الاقتصاد المحلي، دون اقتصاد سوق تنافسي حقيقي، ودون أن تطور البورجوازية هذه خصائص سياسية وثقافية مميزة لها. فهي في المحصلة لا تستطيع قطع حبلها السري عن السلطة الإكراهية ونمط التراكم الأولي المزدهر في ظلها.
وسواء كانت التشكيلة هذه (تراكم أولي ونظام استثناء ورأسمالية سلطة…) مرحلية، على ما قد يتصور الماركسيون الأرثوذكسيون والليبراليون، أم دائمة على ما يظن اللينينيون وأنصار نظرية التبعية، فإن الصيغة الحالية من تطور الرأسمالية في سورية تحول دون عقلنة السياسة والنظام الاجتماعي والثقافة. وقد أسهمت أوضاع الاستثناء، التي نحرز أفضل فهم لها إن اعتبرناها الأطر الحقوقية الأنسب لنمط التراكم الرأسمالي الجاري، في تقويض العالم الأهلي القديم ومراتبه الاجتماعية الموروثة، لكن دون نشوء نظام قانوني أكثر عقلانية. بل إن مقتضيات إدامة نمط التراكم الأولي وإضعاف مجتمع العمل تدفع نحو تنشيط الأهلي، الانقسامي بطبيعته، وربطه بنظام الاستثناء. وهذا هو مصدر التطييف العام الذي يعوق تشكل الأمة وولادة القيم الجمهورية (حرية، مساواة، إخاء…) والمواطنة. وبهذا يفاقم نمط التراكم الجاري من العناصر اللاعقلانية الموروثة في هياكلنا الاجتماعية والثقافية والدينية. لذلك لا نرى فرصا للعقلنة ونشوء الأمة دون تجاوز نمط التراكم الأولي ونظام الاستثناء.
بل إن حالة الاستثناء وبدرجة تتناسب مع إزمانها أخذت تنتج «ثقافة»، أو في اللغة الماركسية «إيديولوجية»، تقوم على الاستثناء، ضرب من الاستثنائية أو الخصوصية السورية، وتتمرد على أية قواعد مطردة تدرج البلاد في قوانين تعمها مع غيرها. وتعثر الاستثنائية هذه على سند إيجابي لها في العروبة أو الإسلام أو المقاومة أو الممانعة. ومعلوم أن الممانعة والمقاومة والصمود والثبات ونظائر لها، وبالخصوص شخصنة السلطة التي هي أعلى مراحل الاستثنائية، هي مدركات أساسية في الاستثنائية السورية. فإن كان هذا التحليل قريبا من الصحة، على ما نفترض، كان أجدى بالأذهان الناقدة أن تبحث عن أسرار «الممانعة» و»المواقف المبدئية والثابتة» في أنماط التراكم المادية. وفي الآونة الراهنة يحصل أن نسمع خطاب الاستثنائية هذه على ألسنة بعض كبار البورجوازيين الجدد أو رأسماليي السلطة، وأن يكون «الإعلام الخاص» هو المجلى الأكثر صراحة في دفع الاستثنائية هذه نحو أقاص انعزالية قلما يطل عليها الإعلام الحكومي.
والغرض أن نقول إن الاستثنائية القانونية والسياسية ليست نتاجا لاستثنائية أو خصوصية سورية أصلية، بالعكس إن الاستثنائية هذه نتاج لنظام استثناء قانوني وسياسي استدام حتى غدا «هوية» البلاد وشخصيتها. أما المحرك المادي للخصوصية فهو نمط تراكم لا يطيق قاعدة مطردة ولا يتحمل قانونا مستقرا. وإنما تستحضر عناصر موروث قديم، ثقافي وديني، لأن الموروث يضفي شرعية أكبر على الاستثنائية والانفصال عن العالم و… التراكم الأولي. ولعل العناصر هذه ضرورية أيضا لتوسيع قاعدة نظام الاستثناء بأن تجلب له ولاء أصناف من «المثقفين»، يزودون أهل التراكم الأولي بالمعاني القومية والدينية و… الماركسية، الاستثنائية والممانعة للعام بدورها، والتي يعجز هؤلاء عن تزويد أنفسهم بها.
خاص – صفحات سورية –
في نستولوجيا المثقف اليساري/ عبد الحسين شعبان
الزمان مكان سائل، والمكان زمان متجمّد
ابن عربي
– I –
ما الذي تبقّى من المثقف اليساري في مجتمعاتنا؟ فهل انقرض أم خفّ وزنه أم ضَعُف تأثيره، وشغلته ظروف الحياة ومشكلاتها عن أحلامه وطموحاته، أم أنه يمكن أن يستعيد دوره وموقعه وألقه؟ أتراه أصبح جزءًا من الماضي وتراثه، ومجرّد ذكريات يحنّ إليها بعضنا بين الفينة والأخرى، أم أن حضوره الحالي والمستقبلي، على الرغم من محدوديّـته، هو جزء من معركته بشكل خاصّ لإثبات وجوده وتأكيد استمراره، وكذلك جزء من معركة اليسار بشكل عامّ، الذي ما بات يعاني من حالة انحسار وانكماش بسبب أزمته الخاصّة وأزمة الحركة اليسارية والتحرّرية بشكل عام؟
يمكن هنا تسليط الضوء على ما ذهب إليه “ميشيل فوكو”، وخصوصاً في مقالته التي تحمل عنوان “المهمّة السياسية للمثقّف” ردّاً على سؤال وجِّه له: “هل بوسع المثقف اليساري أن يفعل شيئاً بوصفه فاعلاً، وبوصفه الوحيد القادر على الفعل داخل حراك اجتماعي؟”، وكان جوابه: “إنّ الرأي الذي يقول إنّ تدخّل المثقّف بوصفه مُعلّماً أو صاحب رأي، لا أتبنّاه… لأنني أعتقد أن الناس ناضجون بما يكفي كي يقرّروا…”.
ولعلّ نظرة مثل هذه، تشكّل خروجاً على الفكرة التبشيرية لدور المثقف في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تلك التي كانت تعطيه دوراً ريادياً في تبصير الناس وتنويرهم وتوجيههم نحو التحرّر.
لقد أعلن فوكو بذلك “نهاية المثقّف”، خصوصاً عندما اعتبر مفهوم المثقف ذاته غامضاً وعائماً، فالمثقف مذنبٌ حين يصمت وحين يتكلّم وحين يكتب وحين يستقيل، لأن وظيفته الجديدة، بحسب فوكو، هي النّضال ضد مسلّماته، فهو إما أن يكون ملتزماً أو مزيفاً، وهو ليس وسيطاً عقارياً بين آيديولوجيات، لأنه ينبغي أن يكون صوت المظلومين والصامتين والمهمّشين.
وقد كان “أنطونيو غرامشي” صاحب فكرة “المثقف العضوي”، وهي المقولة الأثيرة التي ظلّ أصحابنا الماركسيون واليساريون يستخدمونها بمناسبة ومن دون مناسبة، وقد عني بها الاقتراب من الجماهير، والعمل وسط المواقع الدقيقة للحركات الاجتماعية، بل التماهي معها.
لا يتحدّث بعض مثقفي اليسار، ولا سيّما العربي في الكثير من الأحيان، عن الحاضر أو المستقبل، لكنه يغوص في الماضي ويستغرق فيه مستذكراً بشغف أيّامه الجميلة كما يسمّيها أحياناً، يوم كان دوره مؤثّراً وصوته هادراً وإبداعه راقياً. ربما يجد في تلك النستولوجيا “الحنين إلى الماضي” تعويضاً عن حاضر باهت ومستقبل مجهول وأحلام مُنكسرة، وقد يرجع ذلك إلى شعوره بأنّ الماضي معروف، وهو يستحضر جزءه المشرق، أما الحاضر فلا يزال ملتبساً والمستقبل لا يُبشّر بالخير حسب معطياته.
في نبرة المثقف اليساري تشعر أن ثقته بالمستقبل ضعيفة، بحكم موقعه المتواضع والتابع أحياناً، لذلك يتشبّث بالتاريخ وبالماضي، كجزء من محاولة البقاء، وهي سمة عامة لنا نحن العرب، الذين نتحدّث عن ماضينا “التليد”، أكثر ممّا نتحدّث عن حاضرنا ومستقبلنا.
وبالطّبع تختلف مهمّات المثقف اليساري الراهنة عن مهماته السابقة، وكذلك وسائل وأساليب تحقيق أهدافه، ناهيك بأدواته، وهي أمور لا بدّ من أخذها بنظر الاعتبار عند تناول دور المثقف وأفقه المستقبلي في ظلّ الأزمة الراهنة وسُبل الخروج منها.
صحيح أن التراجع والانكسار والخذلان والخيبة هيمنت على المثقف اليساري، أو مثقف التحرّر الوطني، كما يطلق عليه بعضهم، باستثناء قلّة ظلّت متشبّثة بممانعتها ومقاومتها ورفضها لمشاريع ومخطّطات تريد فرض الأمر الواقع على شعوبنا وبلداننا، وعلى الثقافة والمثقفين من جانب جهات متسيّدة ومتنفّذة خارجية وداخلية، لكن حتى بعض هذه القلّة يعيش هو الآخر في الماضي، ولا يريد تطوير أدواته لمواجهة الحاضر واستشراف المستقبل. والبقية الباقية ليس لديها الوسائل والمستلزمات الكافية للمواجهة بسبب اختلال موازين القوى وتشتّتها “شيعاً وأحزاباً”، لكنها ظلّت حريصة على أن يبقى صوتها مستقلاً ونقدها مستمراً.
تحاول الجهات المتنفّذة على الثقافة والمثقفين فرض منهجها، تارةً باسم “العولمة” وتارةً أخرى باسم “التغيير والدمقرطة”، وفي تارة ثالثة تحت عنوان “مواجهة التغريب والاستكبار” ولكن من موقع السلفية والماضوية، وبين هذا وذاك من المشاريع الكبرى، يتم إلغاء أو تحجيم فردانية المثقف، وتحويل إبداعه إلى مجرّد دعاية وترويج لمصلحة الحاكم أو صاحب القرار أو السياسي المتسلّط، بما فيها في المعارضات أحياناً، سواء بزعم مواجهة العدوّ الخارجي والخطر الأجنبي الداهم، وأخرى باسم المصلحة الوطنية العليا وأهداف الثورة، وثالثة باسم الدّين، أو باسم المذهب أو غير ذلك من التبريرات التي تعود إلى مرحلة ما قبل الدولة.
وإذا كان النضال ضدّ الإمبريالية وربيبتها الصهيونية، ومن أجل الاستقلال والانعتاق والتحرّر الوطني والوحدة الكيانية العربية والعدالة الاجتماعية، هي الأساس الذي اعتمده المثقف اليساري في مرحلة التحرّر الوطني في الأربعينات والخمسينات من القرن الفائت وما بعدهما، فإن هذا النضال اتّخذ أشكالاً جديدة، وإنْ كانت محدودة، لكن مرجعيتها الفكرية أخذت بالاتّساع والعمق، ويمكن أن تكون نواة أوّلية لما أسماه “أنطونيو غرامشي” بـ”الكتلة التاريخية” التي تحتاج إلى جهود جبّارة من المثقفين للوصول إليها في إطار أجواء حوار ومصالحة بعد مصارحة بين التيارات المختلفة.
– II –
أهي نهاية المثقّف العضوي؟
نعود إلى السؤال: أين المثقف اليساري، الماركسي والقومي العربي والليبرالي الوطني؟ وكيف يمكن توظيف إبداعه ليستعيد دوره؟ ومن حقنا، بعد الارتكاس والتقهقر الذي تعرّض له المثقف، أن نصوغ السؤال الملغوم: أهي نهاية للمثقف العضوي بحسب غرامشي؟ وهل بإمكان “تفاؤل الإرادة” تغيير “تشاؤم الواقع”، أم ثمة عوامل ينبغي استكمالها لتحقيق ذلك؟ وهل صعود مثقف العولمة والمثقف النيوليبرالي هي نهاية للمثقف اليساري؟ أم ثمة دور يمكن أن يضطّلع به المثقف اليساري في إطار مشروع نهضوي عربي جديد، يقوم على مرتكزات أساسية هي الاستقلال السياسي والاقتصادي والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والوحدة العربية والتجدد والانبعاث الحضاري، ومرّة أخرى أين رمزية مثقف الأربعينات والخمسينات وكارزميته من رمزية مثقف اليوم؟
لقد أسهمت الحقبة البترودولارية في إضعاف المثقف اليساري ومحاصرته، وأدّت تدريجياً إلى نكوص دوره أو انكفائه أو شعوره بالانكسار والخذلان في ظل توازن قوى ليس لمصلحته، وخصوصاً فشل المشروع الاشتراكي واليساري والتحرري عموماً، وانهيار النموذج “البلدان الاشتراكية” التي يمكن أن نطلق عليها “أنظمة الأصل”، وتقهقر بلدان التحرّر الوطني أي “أنظمة الفرع”.
الأمر لا يعود إلى هشاشة أو ضعف مناعة بعض المثقفين اليساريين فقط، وإنما ينبغي التوقف عند الدور التدميري الخطر الذي لعبه مثقف العولمة في تدهور مكانة الثقافة والمثقف بشكل عام، وخصوصاً إزاء محاولة تزييف الوعي وتزيين الواقع ورسم صور وردية، عن النظام العالمي الجديد، والتبشير بقيمه تحت عناوين الدور الريادي لليبرالية الجديدة، وهو ما دعا إليه “فرانسيس فوكوياما” في نظريته “نهاية التاريخ” وصموئيل هنتنغتون في أطروحته “صدام الحضارات”.
لقد حاول “إدوارد سعيد” أن يفحص بدقّة الدور المتغيّر للمثقف العربي، من خلال مقاومة إغراءات الجبروت والمال، وفي تعريفه للمثقف يقول: “هو شخص يواجه القوة بخطاب الحق”، ويصرّ على أن وظيفته هي أن يُخبر مريديه ونفسه بالحقيقة، وقد جمع بذلك عمق معرفته، وصرامة أدواته البحثية، وأخلاقية ما يقوم به من أفعال سياسية.
وفي ظل الصراع الآيديولوجي العالمي، استُخدمت وسائل متعدّدة من الدعاية البيضاء والسوداء للتأثير على المثقف وجرّه إلى حلبة الصراع، وخصوصاً أن وتيرته الدعائية كانت تسير بكثافة وسرعة لامتناهية. وتعرّض الكثير من المثقفين، في فترة الحرب الباردة، في كلا المعسكرَين المتصارعَين، إلى التنكيل والتهميش إن لم ينصاعوا إلى الإرادات السياسية، وكان بعضهم بين مطرقة الغرب وسندان الشرق.
وهكذا كان المثقف عموماً، واليساري خصوصاً، عرضةً للتجاذب بين الاعتراض والمقاومة والممانعة وبين الخضوع والاستسلام والمُسايرة. وحين انهارت الكتلة الاشتراكية، تبدَّل كثير من خرائط بعض المثقفين اليساريين، فوجدوا في العولمة والخصخصة وازدراء الاشتراكية واعتبار الليبرالية “الجديدة” مفتاح الحلول في العالم المعقّد!
كيف تمكّنت القوى العولمية، باسم الحداثة وما بعد الحداثة، من إقناع المثقف اليساري الذي كان يعتبر الإمبريالية والصهيونية العدوّ رقم واحد للشعوب، بأنها “مُحرّر الشعوب” وفاعل الخير المخلّص والمُنقذ من أنياب الدكتاتوريات والأنظمة المستبدّة، لبناء مجتمع الخير والرفاه والوفرة والحرّيات والمساواة، أي مجتمع الحليب والعسل والرفاه، كما هو “العالم الحرّ”؟!
وأخيراً، ما هو السبيل لاستعادة دور المثقف، باعتباره فاعلاً ومؤثراً، وليس تابعاً أو مُلحقاً أو مُستزلماً وخانِعاً؟ وما هي الوسائل الجديدة لمجابهة ثقافة العولمة، وخصوصاً في ظلّ واحدية إطلاقية تكاد تكون شاملة في الميادين المختلفة؟ هل الاكتفاء بالشعارات والصّيغ القديمة، كفيل بمواجهة العولمة بوجهها المتوحّش، أم لا بدّ من وسائل جديدة تستند بالدرجة الأساسية إلى العِلم واستثماراته، وخصوصاً في جيل الشباب، لتنمية العقول والمدارك، واستيعاب مُنجزات الثورة العلمية – التقنية بما فيها من تكنولوجيا الإعلام والمواصلات والاتصالات والطفرة الرقمية “الديجيتل”؟.
والأمر يتعلّق بضرورة مراجعة المثقف اليساري لتجربته، ونقدها، والتخلّص من الجمود التي صاحبها، وخصوصاً التجارب الشمولية التي قادت إلى الإقصاء والتهميش والانتقاص من قيمة الحرّية والفرد والفردانية، على حساب الشعارات الكبرى ذات الرنين العالي، كالمساواة، وإن كانت ذات طابع شكلي، والعدالة التي كانت ناقصة ومبتورة في ظلّ شحّ الحرّيات، علماً بأن واقع الأمر كان يسير في اتجاه آخر.
ويحتاج الأمر كذلك إلى وضع قضية الحرّيات في موقعها الصحيح، ولا سيّما حرّية التعبير وحرّية الاعتقاد والحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية، والحق في الشراكة في الوطن الواحد والمُشاركة بتولّي المناصب العليا في الدولة والمجتمع من دون تمييز لأي سبب كان، سواء إثنياً أو دينياً أو طائفياً أو بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل الاجتماعي. فالتحوّل الديمقراطي المنشود لن يتمّ من دون تأمين مستلزمات احترام سيادة القانون واستقلال القضاء وتداول السلطة سِلمياً، وتلك من واجبات المثقف بشكل عام، والمثقف اليساري بشكل خاص.
ولا بدّ للمثقف أن يعمل على إعادة تفعيل دور الجامعات، وإعادة النظر بالمناهج التربوية ومؤسسات البحث العلمي، وتجسير الفجوة بين المثقف وصاحب القرار، أي أن يمارس دوره كقوّة اقتراح وليس كقوّة احتجاج فحسب، فضلاً عن مطالباته بتحسين الخدمات الصحية والتربوية والبلدية، وجعلها في خدمة الجميع، وكذلك تحسين أوضاع الناس وتقليص الفجوة بين المتخومين والمحرومين، وبين مَن يملكون ومن لا يملكون، ولن يتم ذلك سوى بنضال سلمي مدني طويل الأمد، يلعب فيه مثقف اليسار، الماركسي والقومي، دوراً مهماً في المُمانعة وفي مواجهة تغوّل القوى الدولية والمحلية وهضمها للحقوق والحرّيات الديمقراطية، ومحاولاتها فرض الاستتباع عليه بالوعد أو الوعيد، بالترغيب أو بالترهيب، خصوصاً بتجديد منهجه وأساليب عمله، مستفيداً من الإعلام ومستخدماً إياه، إلى جانب الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني على هذا الصعيد.
– III –
بين أُمميَّـتَيْن
إن المثقف اليساري في المرحلة الجديدة، هو أقرب إلى المثقف الكوني، فالحدود أمامه مفتوحة، والجسور موصولة، وجميع وسائل الاتصال والتكنولوجيا يمكنه استخدامها للتواصل مع مثقفي العالم من موقع التضامن والتساند والأهداف المُشتركة والطرق المختلفة لتحقيق تلك الأهداف لكل منهما، بحسب ظروف كل بلد وخصائصه وتطوّره ودور اليسار فيه، وتلك النظرة الأممية الجديدة مختلفة عن الأممية الشيوعية أو الاشتراكية السابقة، التي قامت على وجود مركز مقرّر وفروع تابعة له.
هل نحن أمام أمميّة جديدة؟ وما الفرق بينها وبني الأمميّة القديمة؟ ثمّة أممية جديدة في طور الإنشاء أو في مخاض للتأسيس، وخصوصاً في جانبنا الفكري والثقافي، وصولاً إلى أممية ثقافية كونية طوعية واختيارية، قائمة على أساس التفاهم والتضامن والمساواة، ومن دون قسر أو إكراه أو إملاء للإرادة، فالمثقف اليساري اليوم، لا يستطيع تحقيق أهدافه العامة والخاصة، من دون انخراط في حركة واسعة ومرنة لليسار العالمي، وخصوصاً لمواجهة التغوّل الإمبريالي العولمي وذيوله المحلية.
وإذا كانت هذه نظرتنا إلى مثقف اليسار، وما تبقى منه، وصولاً إلى المثقف الكوني، كأحد عناصر المُجابهة لتحقيق التنمية والرفاه والتقدّم، فهي رؤية عدد من المثقفين اليساريين الآخرين، بلورها “إدوارد سعيد”، الذي شكّل الصورة الحضارية للمثقف الفلسطيني في أفضل رموزه، باعتباره مثقفاً كونياً مُنحازاً للإنسانية، يعيش عصره على نحو جدلي، ويحلّل الظّواهر بعقل معرفي ومنهجية فكرية أساسها النقد، وهو معني بكشف هذه الظواهر وتحليلها وتفكيكها واستنطاقها، مثلما فعل “هابرماز”، و”دريدا”، و”تودروف”، و”آلن تورين” وغيرهم، وتتجلّى مرجعيّـته الأساسية الموجِّهة لعمله في الممارسة النقدية التي تتعرّض لفكّ التداخل بين الظواهر التي يدرسها.
في كتابه “الاستشراق” لم يتّهم إدوارد سعيد مثقف السلطة فحسب، بل السلطة ذاتها التي تقولب “المثقفين”، ولكنه دافع عن المثقف وعن الاختلاف والمُغايرة، وذلك ما بحثه تفصيلياً في كتابه “الثقافة والإمبريالية”، مُعتبراً الثقافات والحضارات تتلاقح وتعيش بعضها على بعض، وبخصوص الهويّة، فقد عبّر سعيد عن ازدواجيتها، فمن جهة هي هويّة مختلفة، ومن جهة أخرى هي هويّة مؤتلِفة.
إن كتاب “خارج المكان” هو محاولة لإحياء الذاكرة، أي إبقائها حيّة، والبحث في التفاصيل الصغيرة، التي تشكّل عوالمها مهمّة أساسية يستعيدها المنفيّون واللاّجئون. وهو بهذا المعنى بحث في الهويّة، على الرغم من العواصف، والتنقّلات والهجرات والثقافات. فالهويّة ظلّت تشكّل الهاجس الذي يطلّ برأسه ويلوح بصورة عفوية، من دون استحضار مسبق. وقد سبق لـ”أمين معلوف”، الروائي اللبناني العالمي الذي مُنح أعلى وسام فرنسي، أن تحدّث عن موضوع الهوّية في كتابه “الهوّيات القاتلة”؛ وقد مثّل هو شخصياً هذا البُعد المُتحرّك في الهويّة، بحمله الثقافتين العربية والفرنسية، وقدرته في أن يكون جسراً للتواصل، من دون أن يعني ذلك تجاوز المعاناة الإنسانية الفائقة، ولا سيّما في التعبير عن تلك الهويّات المزدوجة، بل المتعدّدة والمتنوّعة.
أما “أدونيس”، ففي كتابه “موسيقى الحوت الأزرق” يُناقش فكرة الهويّة، ويستهلّ حديثه بالعبارة القرآنية التي تضيء، بقِدَمِها نفسه، حداثتنا نفسَها على حدّ تعبيره، وأعني بها التعارف، أي الحركة بين الانفصال والاتصال في آن، من خلال “رؤية الذّات، خارج الأهواء”، ومنها بخاصة الآيديولوجية، ويمكن أن نضيف إليها الدينية والقومية وغيرها، بمعايشة الآخر داخل حركته العقلية ذاتها، في لغته وإبداعاته وحياته اليومية.
وتستند هذه الرؤية إلى إحلال الفكر النقدي التساؤلي، محلّ الفكر التبشيري – الدّعائي، حيث يصبح الوصول إلى الحقيقة، التي هي على طول الخط تاريخية ونسبية، وصولاً يُشارك فيها الجميع، على الرّغم من تبايناتهم إلى درجة التناقض أحياناً، وهذا يعمّق الخروج إلى فضاء الإنسان بوصفه أولاً، إنساناً، ويدفع الذات إلى ابتكار أشكال جديدة لفهم الآخر. ثانياً وثالثاً يكشف لنا أن الهوّية ليست معطى جاهزاً ونهائياً، وإنما هي تحمل عناصر بعضها مُتحرّكة ومُتحوّلة على الصعيد الفردي والعام، وهو ما يجب إكماله واستكماله دائماً في إطار مُنفتح بقبول التفاعل مع الآخر. وإذا كانت ثمّة تحوّلات تجري على الهويّة على صعيد المكان – الوطن، فالأمر سيكون أكثر عرضة للتغيير بفعل المنفى وعامل الزمن وتأثير الغربة والاغتراب.
وكان إدوارد سعيد قد قال بعدم وجود هويّة صافية، وإنما الهويّات جميعها مُركّبة من عناصر مختلفة وتراثات متنوّعة، وعليه فالهويّة كما يقول أدونيس: ليست بركة مُغلقة، وإنما هي أرخبيل مفتوح، أي أنها، بحسب سعيد، ليست ثابتة أو جامدة أو نهائية. إنها حيوية وديناميكية تغتني باستمرار مع عناصر ثقافية متجدّدة، وهذه هي شخصية سعيد ذاته، فهو فلسطيني أمريكي الجنسية، يرى ذاته في الآخر، ويرى الآخر في ذاته، من دون أي وقوع في التبسيط أو السذاجة.
ولذلك يقول سعيد في كتابه “خارج المكان” إنه “عربي أدّت ثقافته الغربية، ويا لسخرية الأمر، إلى توكيد أصوله العربية، وأن تلك الثقافة، إذْ تلقي ظلال الشكّ على الفكرة القائلة بالهويّة الأحادية، تفتح الآفاق الرحبة أمام الحوار بين الثقافات”.
وفي آخر حوار معه أجرته صحيفة “الرأي العام” الكويتية في 27 سبتمبر/أيلول العام 2003 قال: “هناك تهديد للمشروع الحضاري العربي، وللأسف يُسهم العرب في هذا التهديد. ثمّة نوع من الانتحارية العربية تنعكس في السياسة العربية، وهي لا تؤدي إلى مستقبل إيجابي، وهناك تغييب في المفاهيم العربية، وأنا شخصياً أعاني من ذلك في الغرب”، وقصد سعيد من ذلك الدعوة للحوار والتسلّح بالحضارة والعِلم والتعليم.
من هو المثقف الكوني؟
ونعرض هنا وجهتَي نظر متميّزتَين لمثقفَين يساريين، الأولى لمثقف يساري اشتراكي حاول تقديم قراءة جديدة ونقدية بجرأة وشجاعة للتراث العربي – الإسلامي، من خلال مفهوم مُستحدث للمثقف الكوني، ونعني به الباحث العراقي “هادي العلوي”، والثانية لمثقف يساري واشتراكي أيضاً، قرأ التطوّرات الجديدة بعد انهيار الكتلة الاشتراكية من زاوية نقدية، وعمل على المشاركة في تقديم تصوّر حقوقي لمواجهة تداعيات مثقف التحرّر الوطني وتصدّعاته، وذلك بطرح مفهوم المثقف الكوني، ونقصد بذلك الباحث المصري المجدّد “محمد السيد سعيد”.
– IV –
المثقف الكوني، بحسب هادي العلوي، هو “المتصوّف أو التاوي”، الذي يتميّز “بالتجرّد الكامل واللاّتشخّص واللاّحدود واللاّتناهي”. ويقيم على الوحدة المطلقة “بإلغاء المسافة بين الخلق والخالق والتوحّد معهما”. ويضيف العلوي صفات أخرى إلى “المثقف الكوني” الذي يُفترض فيه “عمق الوعي” المعرفي والاجتماعي معاً، و”عمق الروحانية” (السلوك الروحاني وليس الفكر الروحاني “الغيبي”)، وهذه الصفات هي: القوّة أمام مطالِب الجسد والترفّع عن الخساسات الثلاث السلطة والمال والجنس.
إنّ نموذج المثقف الكوني هو أقرب إلى التماهي مع أهل الحق في الإسلام “فقهاء القرن الأول والمتكلّمون والأحبار المستقلّون المعدودون في الطّور قبل الصوفي، ثم المتصوّفة أقطابهم من دون صغارهم…” ويمثّل “التاوي” و”المسيح”، كما ورد في كتابه “المرئي واللاّمرئي في الأدب والسياسة”: التماهي مع روح الخالق، بعيداً عن السلطة والتعفّف عن المال، مردّداً قول السيّد المسيح حين دعا إلى إخراج الأغنياء من ملكوت الله. ويمنح العلوي مثقفه الكوني: هوّية مُعارضة، أي لقاحية، كما يسمّيها، لمواجهة التشخّص والمحدودية والتناهي. وبذلك يفسح في المجال أمامه لاختيار الطريق للوصول إلى الله/ الحق، والانحياز ضدّ مركزية الدولة والدّين المُمأسَس والأغنياء.
من “تكوينات المثقف” الكوني لدى العلوي: “التعالي على اللذائذ”، بحيث يأخذ من الحياة ما يفرضه دوامها، فيأكل عند الحاجة، وينام عندما يغلبه النوم، “ولا يملك شيئاً لئلاّ يملكه شيء، وهو كبير وقوي وحاكم” (المقصود حرّ وغير خاضع لسلطة)، وليس صغيراً أو ضعيفاً أو محكوماً. ويوجّه العلوي نقداً للمثقفين المعاصرين العرب، ولا يستثني أحداً، وذلك وفقاً لقياساته المسطرية حين يقول: “المثقفون مأخوذون بالخساسات الثلاث ويجعلونها من صميم العمل الثقافي”. ويمضي إلى القول “لقد سبقني إلى مُعاداة المثقف شيخنا فلاديمير لينين، حين اتّهمهم بالرخاوة والروح البرجوازية”.
لقد أطلق عليهم العلوي اسم “شيوعية الأفندية” (الأفندي السيد الكبير باللغة التركية) وقَصد بذلك نمطاً من الشيوعية يقوم على الآيديولوجيا الصّرفة المُجرّدة من اليوتوبيا المقطوعة عن ساحة الصراع الطبقي. ويعتبر هؤلاء “مثقفين وشيوعيين يحاربون الشيوعية”، وهو ما سمّيناه في كتابنا “الصراع الآيديولوجي في العلاقات الدولية” الماركسلوجيا مثلما هناك “إسلاميون يحاربون الإسلام”.
ويعتبر هادي العلوي أن المثقف الصوفي ومَن حكمه متروحِنْ بعلاقة مزدوجة مع الروح الكونية، التي يسميها الباري أو الحق أو التاو، مع الخَلق في آن واحد.
وبتلك “الرَوْحنة” يكتسب المثقف، بحسب العلوي، الطاقة الاستثنائية التي تضعه في مواجهة السلطات الثلاث: سلطة الدولة وسلطة الدين وسلطة المال. وفي هذا الطّور الأعلى من الاستقطاب، يتخلى المثقف الكوني عن “اللذائذية”، باختلافه عن عـالم الدين وربما عالم الطبيعة. إنه بذلك يعّبر عن نكران ذاته وتخلّيه عن حقوقه لمصلحة الإنسان (الآخر)، وهو يردّد قول عبد القادر الجيلي “أفضل الأعمال إطعام الجياع”، حين يتمنّى أن يملك الدنيا ليوزّعها على الفقراء، فتلك كانت رؤيـة العلوي الحقيقية إزاء الفقراء، فقد كان لا يريد بقاء الامتيازات محاصصة – بين “أهل الدولة” و”أهل الدين”، بل تساوياً مع العامة.
ووضع العلوي أعداء المثقف الكوني في دوائر أربع سمّاهم “الأغيار الأربعة” وهم: الحاكم والمثقفون والرأسمالية والاستعمار، معبّراً في بياناته المشاعية وعلاقاته الروحانية عن تحدّيهم، وخصوصاً أنه كان يعيش بفكره مع شيوخ الصوفية الذي يقول عنهم : “أنا أعيش بينهم وأكلّمهم، وأنا دائم الحديث مع النّفس في الخلوات… من لاوتسه إلى ابن عربي”.
وإذا كان العلوي لا يعتبر “التملّك” غريزة لدى الإنسان، بل صفة مكتسبة، فإنه بحسب تقديري، رغبة منه في النزوع إلى الحق المطلق “المثالي” والوقوف ضدّ الاستغلال من زاوية إنسانية “مطلقة”، ولكنني أعتقد أن الرغبة في التملّك متأصّلة في الإنسان وفي النفس البشرية، فضلاً عن أنها حق شخصي للإنسان، ولذلك ورد ذكرها في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” الصادر عام 1948 (المادة السابعة عشرة) التي نصّت على: “أن لكل شخص حق التملّك ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّفاً”.
وعندي أن ذلك أقرب إلى طبيعة النفس البشرية على مرّ التاريخ، ولهذا السبب انشغل علماء الاجتماع والقانون والاقتصاد والسياسة في بلورة الآراء والتوجّهات بخصوص تنظيم الملكية، في بحث مستديم عن العدالة الاجتماعية، الهاجس الذي يبحث عنه بنو البشر على مرّ العهود. كما كرّست الدساتير والقوانين والأنظمة على مرّ العصور الكثير من حقولها لتنظيم الملكية وتحديد وظيفتها، سواءً الملكية الفردية أم الاجتماعية، بحيث تعود بالخير على المجتمع ككل، وكان هذا جوهر الصراع أيضاً بين المدارس الفكرية والفلسفية، المثالية والمادية.
أما “الجنس” الذي يعتبره العلوي غريزة يتساوى في طلبها المثقف الشرقي مع الحاكم الشرقي، فمن خصائص المثقف الكوني، بحسب العلوي، الابتعاد عنه، لأنه من الخساسات الثلاث، أو طلب القليل منه والاكتفاء بحدود الوظيفة، في حين أن الحاكم لا يرتضي بالكثير، بينما لا يطلب مثقفه الكوني سوى القليل.
وهنا أيضاً أجد اختلافاً مع الطبيعة البشرية، فالجنس حاجة إنسانية يتساوى في طلبها المثقف والحاكم، وإشباع هذه الحاجة يتساوى فيها الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والمثقف مع غير المثقف. صحيح أن الظروف الاجتماعية ودرجة التطوّر والوعي والوفرة المالية، قد تحدّ أو تزيد من مدى إشباع هذه الغريزة أو الرغبة، لكن الأساس فيها يبقى هو الحاجة الإنسانية، بغض النظر عن عناصر الاختلاف الأخرى.
أخيراً، أقول إذا كانت نزعة التصوّف قد استوطنت العلوي واحتلّته احتلالاً، فإنه استحلاها واستطيَبها، وعاش معها ليؤنس، “الإله” في ذاته المغتربة عن العالم.
– V –
مثقف التحرّر الشامل
أما “محمّد سيّد سعيد”، فإنه يتناول بزوغ ظاهرة “المثقف الكوني” أو “الكوكبي” الذي من خصائصه الأداء الداخلي الناجح في مجالات النمو (التنمية) والتقدّم كافة، وكل إنجاز داخلي في ميادين “الصحة” و”التعليم” و”التكنولوجيا” و”الثقافة” و”الاقتصاد” يصبّ في هذا الاتجاه، وخصوصاً باختلاف المضمون الحقيقي لمشروع التحرّر الوطني، فلم يعد هذا المشروع ينهض على الصّدام مع الغرب (الاستعمار والإمبريالية سابقاً)، بل عملية تحرّر عملاقة من علاقة الضدّية الحاكمة (على نحو عكسي) بين تجربة وطنية ما من ناحية، والغرب من ناحية أخرى.
يقول سيد سعيد في مقالة بعنوان “نهاية مثقف التحرر الوطني” (جريدة الحياة 3/9/1994): “يستحيل أن تُستكمل عملية التحرّر هذه بالعودة إلى المنطق الطبيعي لأي اختيار، أي قياس عائد وتكلفة أي اختيار، ومدى اقترابه أو ابتعاده من قيَم سامية لعموم الإنسانية. ويدعو سيد سعيد إلى ولادة عربي جديد “مثقف التحرّر الشامل” الذي هو “مثقف كوني” بالضرورة، لأنه يُدرك أن عملية التحرّر هي فعل عالمي، وهو بالتالي “يتصوّر فاعليته في إطار تحالف عالمي، فضفاض نسبياً، من أجل السلام والمساواة والرفاه للعالم كله”. ويعرّف محمد السيّد سعيد مثقف التحرّر الوطني، بأنه ذلك الكائن الذي تفتَّح وعيه الكوني على صدمة الاستعمار والهيمنة الغربية على عالَمه القومي.
بهذا المعنى، فإن مثقف التحرّر الوطني يقف ضدّ التجزئة، ويناضل لبناء دولة الوحدة وليس تحقيق “الاستقلال الوطني”. إنّ مثقف التحرّر الوطني هو وليد “اتفاقية سايكس بيكو” العام 1916، وأضيف إليها منذ العام 1948 بُعد جديد جوهري، هو نشوء “الدولة العبرية” واغتصاب أرض فلسطين، فلم يعد نضاله يقتصر بحسب سيد سعيد على قيام دولة الوحدة وضدّ التجزئة، بل يناضل (بالضرورة) ضدّ المشروع الصهيوني الاغتصابي – التوسعي. وهو بالطّبع نضال ضدّ الغرب الداعم لقيام إسرائيل.
ويصل السيد سعيد إلى استنتاجات مثيرة، منها أن المثقف العربي سجن نفسه في الإطار التكنوقراطي البحت، الأمر الذي أدّى إلى تعقيم (من العُقم) طاقاته الفكرية والإبداعية وأفقده الخيال الجسور، بحيث انهمك في تحسين أداء ما هو قائم ولترقيع ما هو مهترئ ومختوم. (وهو يقصد بذلك مثقف السبعينات والثمانينات وما بعدها، علماً بأن مثقف الأربعينات والخمسينات ولغاية الستينات كان دوره مختلفاً وريادياً).
لقد أصبحت للغرب دعامتان أساسيتان في المنطقة: الأولى – “ضمان تدفّق النفط” بأرخص الأسعار والثانية – “ضمان أمن إسرائيل” ودعم مشاريعها التوسعية والعدوانية. وأصبح مثقف التحرّر الوطني نفسه، أسيراً لشعارات الصراع الآيديولوجي القديمة ولفترة الحرب الباردة، فأصبح دعم الاتحاد السوفييتي “ضرورة تأريخية”، بغضّ النظر عن التعقيد الجديد في تلك العلاقة، بما فيها نخبة مثقفي التحرّر الوطني والشعارات التي كانت ترفعها “القوى الاشتراكية” التي تُبشّر بأفول النظام الرأسمالي، بسذاجة عالية ودعائية تبسيطية “غير علمية”، بحسب تعبير السيد سعيد، وكانت تلك أحد مصادر أزمة المثقف العربي في فترة ترييع الاقتصاد وصعود عنصر النفط، وتجديد الرأسمالية خلاياها وتجاوز بعضها أزماتها. كما يذهب إلى ذلك المفكر المصري “محمود عبد الفضيل” في كتاب جماعي “المثقف العربي – همومه وعطاؤه” (من إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية).
لقد أبدى مثقف التحرّر الوطني إعجاباً شديداً بالنموذج الاشتراكي، ودعا إلى تقليده، وخصوصاً بعد إسهام الاتحاد السوفييتي في القضاء على الفاشية، وغضّ الطرف عن النظام الشمولي، وعدم الإقرار بالتعددي، وإهدار الحقوق والحريات، ولذلك وقف مذهولاً عند الأزمة الطاحنة التي عاشها النموذج الاشتراكي في مطلع الثمانينات، حتى أطيح به في أواخرها، وانهار الاتحاد السوفييتي في العام 1991، لدرجة أن “إيمانيته” العمياء تلك أوقعته ضحية، وهو الأمر الذي دفع الخطاب التقليدي المُنتَج في نهاية الحرب العالمية الثانية في أزمة حقيقية، سواء على الصعيد النظري أم على الصعيد العملي، وازداد الأمر تعقيداً في ظلّ العولمة والثورة العلمية التقنية والاتصالات والمواصلات، لدرجة أن إشكالية “الأصالة والمعاصرة” تعقّدت في جدول أعمال المثقف العربي منذ ربع قرن من الزمان، دون حل مرضٍ.
ولم يكتمل مسار التطوّر الفكري والثقافي، وظلّ يعاني من عدم استقرار ويفتقد في الكثير من الأحيان إلى الحيوية والدينامية. ومع ذلك، وبحسب” محمود عبد الفضيل”، فقد كانت هناك مشاريع فكرية جادة سبحت ضدّ التيار، منها كما يذكر:
1. ثلاثية محمد عابد الجابري (المغرب) حول بنية العقل العربي .
2. ثلاثية جمال حمدان (مصر) حول عبقرية المكان وأبعاده الاستراتيجية .
3. دراسة طارق البشري (مصر) حول إشكالية “الوافد” والموروث.
4. دراسة حسين مروّة (لبنان) عن النزعات المادية في الإسلام .
5. مشروع محمد سلمان حسن (العراق) في إعادة بناء الاقتصاد السياسي في ظل أطروحات أوسكار لانكه وكاليستكي.
6. ثلاثية محمد حسنين هيكل (مصر) عن حروب 1956، 1967، 1973.
ويمكن إضافة مشروع “علي الوردي” (العراق) في دراسة المجتمع العراقي وطبيعة الشخصية العراقية، ومشروع “هادي العلوي” في دراسة التراث ومخالفة ما هو سائد في الكثير من الأحيان، وهناك حقول مهمّة في الأدب والرواية والشعر والفن والعمران، أسهمت في تقديم رؤية للمثقف العربي.
انحسار دور المثقف
لقد انحسر دور المثقف العضوي بحسب مفهوم غرامشي، وهو المثقف الذي يعبّر عن هموم الناس ووجدانهم وحلمهم، والحلاّل لمشاكلاتهم، وسواء أكان مثقفاً يسارياً أو مثقفاً للتحرّر الوطني، فإن المثقف الراهن، توقّف عن إنتاج المعرفة، بل أصبح جلّ همّه هو إعادة توزيعها ترجمةً أو تأليفاً.
وكان المثقف العضوي أو المثقف اليساري والعروبي يدافع عن قيَم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتحرير الشعوب والوحدة الكيانية العربية والتنمية المستقلة، فإذا به الآن يتحوّل إلى قطري، وفي بعض الأحيان محلّي، وخصوصاً في ظلّ مواصفات ما قبل الدولة الطائفية والإثنية والعشائرية والجهوية والمناطقية، ويؤيد التطبيع بحجة الواقعية السياسية، ولا يرى الخطر في الصهيونية والإمبريالية.
هكذا يحاول بعض المثقفين اليساريين تمييع الفروق وإضاعتها. وبحجة فشل القطاع العام وسياسة التخطيط السابقة، يستمرىء البعض الدعوة للخصخصة وبيع القطاع العام، وهكذا بدأت صورته تهتز عند الناس، وخصوصاً بدعوة البعض للتدخل الأجنبي أو التعاطي معه، كما حصل في احتلال العراق، حيث عمل بعض المثقفين مستشارين لقوات الاحتلال، وتعاقد بعضهم الآخر مع البنتاغون، وبرّر آخرون مثل هذه المواقف بحجة وجود نظام دكتاتوري قمعي.
وبقدر ما كان المثقف اليساري أحياناً يدافع عن الدكتاتوريات ويبرّر ممارساتها القمعية، بزعم مصلحة الاشتراكية أو الثورة، فإنه اندفع بعد الانكسارات والتراجعات إلى الدفاع عن التدخّل الخارجي وتبيض صفحة الإمبريالية باعتبارها قادرة على الإطاحة بالدكتاتوريات وتحقيق التغيير المنشود، وخصوصاً بانسداد الآفاق، وتحت حجة الواقعية السياسية والعولمة وغيرها.
وبعد كل ذلك فهل سيتمكّن المثقف اليساري استعادة الدور الريادي والطليعي الذي كان يمثله ويلتحم بالأحداث بقلبه وعقله ووسيلته الإبداعية، أم يبقى ملحقاً بالسياسي وتابعاً له ويبرّر خطابه ويزّين مشروعه ويؤدلج سياساته ويدافع عن انتهاكاته؟
خللان رئيسان ألمّا بدور المثقف اليساري أو مثقف التحرّر الوطني وسلوكه وإنتاجه الفكري، الخلل الأول: هو توجّهه نحو التكنوقراطية والزعم بالحيادية والانصراف عن الشأن السياسي أو الشأن العام، لذلك هَزُلَ منجزه وحيويته وقوته ولونه الخاص، وبعضه صار جزءًا من تزويق الخطاب السياسي الرسمي للحاكم أو للسياسي المتنفّذ، وأحياناً لامتدادات خارجية تحت باب “الدّمقرطة” و”اللّبرلة”.
أما الخلل الثاني: فإن الدعاية والتحريض أصبحا جزءًا من الخطاب السائد على حساب المُنتج الفكري والثقافي العميق، واستُخدم ذلك في الصراع السياسي، سواءً للتيارات الدينية والسياسية من جانب المثقف الممالىء للسلطة، أو بما يتوافق مع الجهات المتنفّذة في المعارضة، وهكذا انحسر دور المثقف العضوي أو دور الطليعة الثقافية وخرج من دائرة التأثير والفعل، إلى التبرير والتسويغ، سواء عبر تطويعه بالقمع السياسي البوليسي أم بالقمع الآيديولوجي الفكري لتبنّي خطاب السلطة أو المعارضة السائد بحيث يكون بوقاً لهما.
الجدب وشحّ الإنتاج
لذلك، فإن الجدب وشحّ الإنتاج شمل الكثير من المثقفين، بحيث إننا لم نشهد نشوء مدارس فكرية جديدة، كتلك التي نشأت في الأربعينات والخمسينات مثلاً في الشعر الحديث والأدب والفن والمسرح والسينما والفن التشكيلي والنحت والموسيقى والغناء وغيرها، فضلاً عن الإنتاج الفكري.
وعاش الكثير من المثقفين عزلتهم الفردية أو عملوا في إطار دكاكين ثقافية، ومن ضمن جماعات صغيرة، في حين كان مثقفو السلطة يتبخترون، حتى دون منجز ثقافي، وهكذا كان حصاد الفكر خلال العقود الخمسة الماضية محدوداً، مثلما هو في الجانب الأكاديمي والجامعي، الأمر الذي أوقع الثقافة وإنتاجها في أزمة عميقة، وحلّ محل أصحاب الإبداع الحقيقي بعض المقاولين والسماسرة الفكريين الذي يملكون الصحف والمجلات ووكالات الأنباء والإذاعات والمحطات الفضائية ومراكز الأبحاث والدراسات، يساراً ويميناً، وبعضها أنشئ بدعم خارجي بهدف تقديم خدمات للجهات المموّلة. ولم تنحسر الفجوة بين صاحب القرار والمثقف، بل ازدادت هوّة وعمقاً، واضطرّت أعداد من المثقفين إلى الهجرة.
وإذا كان، بحسب المفكر والباحث المغربي “علي أومليل” من يتأسّف لعدم الاعتراف بدور المثقف العربي الريادي الذي يطمح إليه، فإن فكرة أخرى انتشرت في السبعينات عن الدور السلبي لسلطان المثقفين في الغرب. فقد راجت فكرة تضخّم سلطة المثقفين، وخصوصاً صنّاع الآيديولوجيات، لكن الأمر ليس موحّداً، فهناك أيضاً من يتحدّث في الغرب عن فقدان العرش الذي كان يتربّع عليه المثقفون منذ قرنَين من الزمان بصعود الحركة التنويرية. (كتابه “السلطة الثقافية والسلطة السياسية”).
إذا كان لا بدّ من دور ريادي للمثقف اليساري، فلا بدّ أن يؤكد المثقف أنه يستحقه وجدير به، وخصوصاً بانحيازه لقيم الحرية والديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والسلام والخير والجمال.
___________
(*) أكاديمي ومفكر عراقي – نائب رئيس جامعة اللاعنف، بيروت.
————————————–