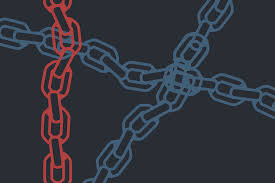وثيقة “مشروع توافقات وطنية” مقالات و ملاحظات مختارة حول هذا المشروع

مشروع وثيقة توافقات وطنية
مركز حرمون للدراسات المعاصرة
هذا المشروع
شكّل موضوع الحوار بين التيارات الفكرية والسياسية السورية الرئيسة أحد اهتمامات مركز حرمون، وكان الدافع إلى هذا الاهتمام هو حالة التشتت والتشرذم الفكري والسياسي التي يعيشها السوريون، بما يهدر طاقات الفرد والمجتمع، وتجعل المجتمع السوري مشتت الفاعلية، وخاصة في سنوات الصراع الأخيرة منذ 2011، حيث تغيب التوافقات المشتركة التي تضمّ طيفًا واسعًا من السوريين، وتتجاوز حالة التشتت والتشرذم، بما يؤطر العمل الفردي في حيّز جمعي قادر على خلق الأثر.
في هذا السياق، أطلق مركز حرمون منذ 2016 منصة هنانو للحوار العربي الكردي، ومنصة الكواكبي للحوار الإسلامي الديمقراطي، وعقد العديد من الندوات والحوارات، وأنجز عددًا من الدراسات لقراءة مشهد التيارات السائدة في الساحة السورية، ونشر العديد من المقالات التحليلية حول موضوعات الحوار.
وبناءً على رغبة العديد من أصدقاء المركز، قام المركز، منذ عام ونصف، برعاية مشروع الحوار الحالي بين التيارات الفكرية والسياسية الرئيسة في سورية، حيث تزداد الحاجة اليوم إلى رؤية متقدمة، لقضايا الوطن السوري الراهنة والمستقبلية، التي تشكّل أسس الدولة السورية القادمة، والتي تصدر عن مجموعة كبيرة متنوعة من النخب السورية متعددة الانتماءات، تمثّل أوسع طيف ممكن من السوريين، وتجسر الهوة بين التيارات والاتجاهات الرئيسة السائدة بين السوريين.
نتيجة المناقشات الداخلية، تم تحديد 12 موضوعًا رئيسًا ذا علاقة بإعادة بناء الدولة السورية، من الموضوعات التي يوجد حولها تباينات كبيرة أو صغيرة، بين التيارات الرئيسة في سورية، وغاية الحوار إبراز نقاط الالتقاء والافتراق وممكنات جسر الهوية والوصول إلى توافقات في الرؤى، وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية:
1. القواعد الدستورية المحصنة التي تحتاجها سورية – 2. نظام الحكم المناسب لسورية– 3. شكل الدولة الأنسب لسورية– 4. علمانية الدولة في سورية– 5. المواطنة المتساوية في سورية– 6. العدالة الانتقالية لأجل سورية– 7. الحقوق والحريات في سورية– 8. معالجة الأزمة الطائفية – 9. معالجة الأزمة القومية – 10. التعليم والتربية في سورية– 11. النموذج الاقتصادي والاجتماعي في سورية– 12. منظمات المجتمع المدني في سورية.
ولمناقشة تلك الموضوعات، نظّم المركز 26 جلسة حوارية، على مدى 13 شهرًا، شارك في كلّ جلسة نحو 20 شخصية سورية من ذوي الاختصاص، من أكاديميين وباحثين ومثقفين وسياسيين، من مختلف الانتماءات. وقد تم إعداد تقرير عن مخرجات كل موضوع.
بلغ عدد المشاركين في تلك الجلسات 186 سوريًّا وسورية، من مختلف الاختصاصات والانتماءات، وكان الحرص كبيرًا لتحقيق أفضل مشاركة ممكنة للتنوّع السوري في كل جلسة من الجلسات، مع مراعاة خاصة لطبيعة كل موضوع.
وإضافة إلى الموضوعات المذكورة أعلاه ومخرجاتها، تمت مناقشة نصوص حول القضايا الأخرى التي لا يكتمل المشروع بدونها، وفي الوقت نفسه، لا يختلف السوريون حولها، مثل: المبادئ العامة – سيادة القانون – الفصل بين السلطات– استقلال القضاء.
خلال هذا المنهج، أتيح لكلّ مشارك المشاركة في مناقشة موضوع واحد أو موضوعين اثنين فقط. ولضمان إشراك الجميع في مناقشة كلّ الموضوعات، تم إعداد تقرير عام بمخرجات جميع جلسات الحوار، التي مثلت الرأي الغالب في جلستي النقاش الخاصتين بالموضوع الواحد. وأُرسل التقرير إلى جميع المشاركين في الجلسات المختلفة، لإطلاعهم على نتائج الجلسات، وإبداء الرأي فيها، وقد تلقّت اللجنة المنظمة للحوار ملاحظات كثيرة على التقرير، واستندت إليها في إصدار هذه الوثيقة التي تسمّى “مشروع توافقات وطنية”.
وإضافة إلى الجهود التي يبذلها عدد من الأصدقاء في مناقشة هذه الوثيقة، وإلى مجموعات عدة تقوم بالأمر ذاته، يضع مركز حرمون الوثيقة على موقعه، من أجل توسيع الحوار حول ما ورد فيها، ويرحّب بكل مساهمة نقدية لهذه الوثيقة، وستنشر المناقشات في موقع المركز؛ فالنقد هو إغناء للوثيقة، وهو مشاركة فعلية في الحوار، وستُضاف أسماء المشاركين في الحوار حول الوثيقة، في حال موافقتهم.
مركز حرمون للدراسات المعاصرة
المشاركات والمشاركون في الحوار [1]
(حسب التسلسل الأبجدي):
إبراهيم الحسين – إبراهيم ملكي – إدوار حشوة – إليس المفرج – إيمان شحود – إيهاب عبد ربه – أحمد الجباعي – أحمد الخالدي – أحمد الرمح – أ ع – أحمد مظهر سعدو – أسامة القاضي – أسامة عاشور – أمينة الخولاني – أيمن أبو هاشم – أيمن عبد النور – آلان حسن – باسم حتاحت – بدر الدين عرودكي – بسام الأحمد – بسام جوهر – بسام قوتلي – بسام يوسف – ب ق – بلند سينو – بهجت لاوند – ثريا حجازي – جبر الشوفي – جمال سليمان – جمال قارصلي – جمانة سيف – حذام زهور عدي – حذيفه عكاش – حسام الحافظ – حسام الدين درويش – حسان الأسود – حسان أيو – حسن النيفي – حسين حمادة – حمزة الرستناوي – حنين علي – خالد الحلو – خالد شهاب الدين – خضر السوطري – خضر زكريا – خلدون النبواني – خورشيد عليكا – خولة الدنيا – راتب شعبو – ربا حمود – ربيع نصر – رديف مصطفى – رضوان زيادة – رفعت عامر – رويدة كنعان – رياض علي – ريزان جابو – ريم خوجة – ريمون المعلولي – زهراء عمر – زيدون الزعبي – سامر الضيعي – س ح – سعاد خبية – سعد وفائي – سلام سعيد – سلام كواكبي – سلمى الدمشقي – سميحة نادر – سمير سعيفان – سميرة المسالمة – سهير أتاسي – سهيل الحمدان – س ز – سيما نصار – شلال كدو – صباح الحلاق – صبيحة خليل – صلاح الدين حنان – صلاح بدر الدين – طارق الكردي – طارق عزيزة – طرفة بغجاتي – طلال مصطفى – ع ش- عبد الباسط سيدا – عبد الحكيم بشار – عبد الحليم سليمان – عبد الرحمن الحاج – عبد العزيز التمو – عبد العزيز الخطيب – عبد العزيز الدغيم – عبد العزيز أيو – عبد الله الحلاق – عبد الله تركماني – عبد الله كدو – عصام خوري – علاء الدين الخطيب – ع د ج – علاء الدين زيات – علي حمادة – عماد الظواهرة – عماد برق – عمر إدلبي – عنان جاكيش – عيسى إبراهيم – غزوان قرنفل – غسان النبهان – غنوة الشومري – فاروق حجي مصطفى – فاروق مردم بك – فايز قنطار – ف ح – فدوى محمود – فراس حاج يحيى – فريال الحسين – فضل عبد الغني – فؤاد إيليا – فؤاد عليكو – كرم دولي – لالا مراد – لمى قنوت – لؤي صافي – لينا وفائي – ليندا النفوري – م س – مازن درويش – مازن عدي – ماسة المفتي – ماهر مسعود – مأمون السيد عيسى – محمد الأحمد – محمد حبش – محمد زهير الخطيب – محمد سرميني – محمد صبرا – محمد علي باشا – محمد مروان الخطيب – محمد ملّاك – محمد نور النمر – محمود الوهب – محمود عطور – مروان الأطرش – مزن مرشد – مسلم طالاس – مضر الدبس – معتصم السيوفي – ملاك سويد – ملك القاسم – مناف الحمد – منى أسعد – منى فريج – منير الخطيب – مهند الكاطع – مهند شراباتي – مهيب صالحة – موفق زريق – موفق نيربية – مية الرحبي – ميداس أزيزي – ميشيل سطوف – ميشيل شماس – نادر جبلي – ناهد بدوية – نائل جرجس – نبيل مرزوق – ندى الخش – نزار أيوب – نشوان أتاسي – نعمت داوود – نمرود سليمان – نواف الركاد – هنادي بطرس – هنادي زحلوط – هند عبود قبوات – هوشنك أوسي – هيثم خوري – وائل السواح – وجدان ناصيف – وسام جلاحج – وفاء سليمان – وفاء علوش – ياسر الفرحان – ياسمين مرعي – يحيى العريضي – يوسف سلامة.
مشروع وثيقة توافقات وطنية
المحتويات:
مقدمة
القواعد الدستورية المحصّنة التي تحتاجها سورية
سيادة القانون في سورية الجديدة
الحقوق والحريات في سورية الجديدة
الفصل بين السلطات في سورية الجديدة
استقلال القضاء في سورية الجديدة
نظام الحكم المناسب لسورية الجديدة
شكل الدولة الأنسب لسورية الجديدة
معالجة الأزمة الطائفية
معالجة الأزمة القومية
العدالة الانتقالية لأجل سورية الجديدة
المواطنة المتساوية في سورية الجديدة
علمانية الدولة في سورية الجديدة
النموذج الاقتصادي والاجتماعي في سورية الجديدة
منظمات المجتمع المدني في سورية الجديدة
التربية والتعليم في سورية الجديدة
خاتمة
مقدمة:
ألحق الاستبداد المديد دمارًا شاملًا في بنية المجتمع السوري ومؤسسات الدولة، إذ صادر الحياة السياسية، وصادر حريّات الناس وحقوقها، خاصة في التجمّع والتنظيم والتعبير عن الرأي، وحرص على تمزيق المجتمع وتعميق الشروخ بين الجماعات السورية، ليتمكن من السيطرة عليه. وقد ترافق هذا مع تعميم الفساد، والفشل في إدارة الدولة من مختلف النواحي، ما ألحق أكبر الأذى بالمجتمع السوري، وشلّ حيويته، ودمّر طاقاته، وأفقره، ومنعه من التقدّم، وحوّل سورية في نظر الخارج إلى دولة راعية للإرهاب والجريمة، ومزعزعة للاستقرار.
في 2011، خرج الشعب السوري مطالبًا بالكرامة والحرية والانتقال السياسي، فووجه بالحل الأمني وبالاستخدام المفرط للقوة، ما تسبّب بقتل مئات الآلاف، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري من بيوتهم، بين نازح ولاجئ، وخلّفَ بلادًا ممزّقة جغرافيًا، إلى أربع مناطق متنابذة متصارعة لا تني تتباعد، ومجتمع ممزق إلى طوائف وقوميات وهُويات متدافعة متنابذة، تقوم بين بعضها أسوار من الريبة وانعدام الثقة، وبين بعضها الآخر أسوار من العداء.
ساهم في هذا الدمار، أو ساعد النظامَ في إلحاقه، معارضاتٌ سياسية أو مسلّحة، فاقدة للرؤية والبوصلة، بعضها براياته السوداء وأجنداته فوق الوطنية، وبعضها بقصر نظره وارتهانه للخارج، وبعضها، مَن يعوّل عليه، بسبب عدم قدرته على العمل والتعاون مع الآخرين، والالتفاف حول مجموعة مبادئ وأهداف مشتركة، وبرنامج وطني للتغيير يحظى بالمصداقية وبقدر من الاحترام في الداخل والخارج، ويشكّل بديلًا ديمقراطيًا ممكنًا للنظام المستبد.
والآن، يوشك الصراع على دخول عامه الثالث عشر، والبلاد مقسّمة عمليًّا إلى أربع مناطق نفوذ، والنظام ما زال قائمًا، والعملية السياسية في حالة ركود واستنقاع لا تبدو لها نهاية، والعالم يدير ظهره مللًا أو يأسًا أو خبثًا أو قلّة حيلة وغيابًا للرؤية، ومن يملكون القدرة على تغيير الأمور مشغولون بصراعاتهم الكبرى، ويستخدمون سورية كساحة من ساحات صراعاتها. أما السوريون الراغبون في وضع بلادهم على سكة الحداثة والديمقراطية، فعاجزون عن الإتيان بأي مبادرة قادرة على الحياة.
أمام هذا الواقع المؤلم، تواضع مجموعة من السوريين المؤمنين بسورية حرة مستقلة ديمقراطية حديثة، من مختلف الانتماءات والأطياف، على إطلاق مشروع الحوار للوصول الى هذه الوثيقة/ التي تحتوي التوافقات بين المشاركين، كخطوة أولي، كي تفتح من ثم على الحوار الواسع، وأن تخضع للنقاش العام والدراسة والتمحيص من قبل جموع المعنيين بالهمّ السوري، كي تحظى بقبول أوسع.
1- القواعد الدستورية المحصنة التي تحتاجها سورية
أ-يحتاج السوريون إلـى رافعـة قوية لإعادتهم إلى بعضهم، بعد الأضرار الفادحة والجروح الغائرة التي ألحقها نظام الأسد بالاجتماع الوطني السوري. وليس ثمة ما هو أجدر بالمهمة من قواعد دستورية يتوافق عليها السوريون، ويعطونها حصانة استثنائية ضد التعديل أو التغيير، فتكون بمثابة صمام أمان، ومصدر للطمأنينة، ومنصة صلبة للخلاص والتجاوز.
ب-والقواعد الدستورية المحصنة، أو ما يعرف عالميًا بالمبادئ فوق الدستورية، هـي قواعـد دسـتورية ذات أهمية خاصة في دولة بعينها، تُعطى حصانة استثنائية ضد التعديل أو التغيير، تفوق الحصانة التي تُعطى لباقي قواعد الدستور. بحيـث يكـون تعديلهـا أو تغييرهـا أو إيقافهـا، نتيجـة تعديـل الدسـتور أو تغييـره أو تعطيلـه، أمرًا بالغ الصعوبة على السلطات.
ت-تكتسي القواعد الدستورية المحصّنة أهمية استثنائية في الحالة السورية، لدورها في تعافي البلاد من جانب، ولكونها صمام أمان للمستقبل من جانب آخر. فهي:
-تعالج المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات السورية، وتعالج مخاوفها وهواجسها المختلفة بشأن حقوقها وحرياتها ومستقبلها، بما يؤدي إلى تخليق قدر من الطمأنينة والثقة بين السوريين، يسمح لهم بالانتقال إلى مرحلة العمل المشترك والتفكير بالمستقبل.
-يمكن، في حال توسعتها، أن تشكل أساسًا متينًا لدستور عصري يضمن الحقوق والحريات، ويحصّن النظام السياسي من تسلل الاستبداد، ويشدّ البلاد نحو مسار الديمقراطية والحداثة، وبذلك تكون بمنزلة منصّة صلبة يقف عليها السوريون لبناء دولتهم ومستقبلهم.
ث-يمكن تلخيص أهم ما يناط بالقواعد الدستورية المحصَّنة من مهام بخصوص سورية بالآتي:
-خلـق منـاخ مـن الثقـة بيـن السـوريين يؤهلهـم للتعـاون والعمـل المشترك والتطلـع نحـو المستقبل.
-ضمان الحقوق والحريات.
-وضع أسس النظام السياسي وشكل الدولة المقبلة.
-تحصين النظام السياسي ضد الاستبداد
-تمكين السوريين من بناء نظامهم الديمقراطي ودولتهم الحديثة.
ج-يجب اختيار القواعد الدستورية المحصّنة وفق معايير دقيقة ومدروسة بعناية، منها:
-عدم مساسها بمبادئ الديمقراطية.
-قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة.
-قابليتها للتجميد، بحيث لا تصطدم بحركة المجتمع وحاجته إلى التطور.
-عدم التوسّع بها إلا بالمقدار اللازم والكافي لتحقيق الغرض.
ح-يجدر بالسوريين العمل بدءًا من الآن على نشر ثقافة القواعد الدستورية المحصَّنة (أو) المبادئ فوق الدستورية بين السوريين، وفتح النقاشات العامة حولها، وتوضيح أبعادها وأهدافها ومبرراتها، وإبراز المصلحة الوطنية العامة والخاصة من وجودها. كما يجدر بهم إعداد الدراسات المعمقة حولها، خاصة حول ما يلزم السوريين منها، وطرق تبيِئتها في المجتمع السوري، وستكون للدراسات الخاصة بتجارب الدول الأخرى قيمة كبيرة.
2- سيادة القانون في سورية الجديدة
أ-سيكون مبدأ سيادة القانون هو حجر الأساس في بناء الدولة السورية الحديثة، دولة القانون والعدالة والحقوق والمواطنة والمؤسسات. بما يعنيه المبدأ من خضوع جميع الأفراد والمؤسسات والكيانات، سواء أكانت عامة أم خاصة (ومن ضمنها مؤسسات الدولة) على قدم المساواة، للقواعد الدستورية والقانونية النافذة، واحتكام الجميع إلى سلطة قضائية نزيهة ومحايدة ومستقلة، لما يعنيه كلّ ذلك من ضمانة للحقوق والحريات، ومن ضمانة لتطبيق العدالة، وبالتالي من طمأنينة لدى المواطنين، وتعزيز لروابط المواطنة ومكانة الهوية الوطنية لديهم.
ب-يجب الحرص في سورية القادمة على ضمان سيادة القانون بكلّ الطرق الممكنة، وعلى رأسها:
نص دستوري مفصل ومحكم، يضبط التشريعات، ويمنع السلطة التشريعية من الالتفاف على قواعد الدستور، وتجاوزها أو تجاهلها، ويضمن الحقوق والحريات، ويضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويُخضع الجميع، خاصة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، لسلطة القانون، ويمنعها من التغول في كل الظروف، خاصة في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ، ويعزز دور القضاء المستقل والمحايد، وخاصة القضاء الدستوري باعتباره صمام أمان مهم لضمان سيادة القانون.
قواعد دستورية محصنة تضمن عدم المساس بالقواعد الدستورية التي تضمن سيادة القانون.
تشريعات مفصلة ومتكاملة تعزز سيادة القانون من كل النواحي.
اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية أساسية للنص الدستوري والنصوص التشريعية.
تحديد دور ووظائف مؤسستي الأمن والجيش، وإخضاعهما للقانون والمساءلة، ولمجلس مستقل عن الرئاسة، وضمان حيادهما السياسي.
تكريس مبدأ دستوري يقضي بسمو الاتفاقات والمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية.
3- الحقوق والحريات في سورية الجديد
أ- تتبنى الدولة السورية القادمة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوثائقها الثلاث، وتعمل على تكريسها دستوريًا وقانونيًا، باعتبارها خلاصة وذروة ما أنتجته الحضارة البشرية في مجال حقوق الإنسان عبر تاريخها، وباعتبارها منظومة متكاملة لحماية الأفراد وتكريس حقوقهم وحرياتهم وضمانها، وقد أصبحت المصدر الرئيس للدساتير حول العالم[2].
ب- يمكن للدولة معالجة مسألة تعارض بعض تلك الحقوق مع ثقافة المجتمع وقيمه السائدة، أو مع بعض العادات والتقاليد والأعراف القارة في وجدان الناس، واجتراح الحلول المناسبة لها، أسوة بدول أخرى ذات أغلبيات مسلمة، وذات مستوى حضاري متقارب، نجحت في تبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإدماجها في منظوماتها الثقافية والحضارية. وهذا ممكن عند توفر الإرادة السياسية والقوانين المتطورة والحكومة الوطنية الكفؤة وبرامج التوعية والتثقيف المناسبة، بمساعدة ودعم من فقهاء عصريين ومتنورين.
ت-السعي إلى إقناع الناس يكون بالحوار وبالتدرج، وعبر آليات واضحة، مع تجنب طرح أفكار ومفاهيم ومصطلحات تحظى بسمعة سيئة لديهم، والاستعاضة عنها بإبراز مضامينها.
ث-للتغلب على صعوبة توفيق قوانين الأحوال الشخصية مع الشرعة الدولية، يمكن إصدار قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية، إلى جانب تلك القوانين الخاصة بالطوائف والمذاهب، ويسري على جميع السوريين، وتترك للناس حرية اللجوء إليه إذا رغبوا بذلك.
ج-تستحق الحقوق والحريات ضمانات عليا من مستوى مبادئ فوق دستورية، كي لا يتم المساس بها في يوم من الأيام، كما تستحق إدخالها في مناهج التعليم في مختلف مراحله.
4- الفصل بين السلطات في سورية الجديدة
أ-يُبنى النظام السياسي في سورية القادمة على مبدأ فصل السلطات، باعتباره مبدأً راسخًا من مبادئ الديمقراطية، وباعتباره ضمانة كبرى للحقوق العامة والفردية، لأنه يمنع تمركز السلطة بيد فرد أو جهة، ومن ثمّ يمنع ظهور الاستبداد[3].
ب-لتمكين مبدأ فصل السلطات وترسيخه في نظامهم السياسي الجديد، سيكون على السوريين:
إدراجه ضمن المبادئ فوق الدستورية الدائمة، وتحصينه ضد التعديل أو التغيير، بحيث يتعذر المساس به مهما امتد الزمن. وذلك أسوة بكل مبادئ الديمقراطية.
التفصيل في أسسه وأحكامه ضمن الدستور، لسد أي ثغرة يمكن استغلالها.
اتخاذ كل الاحتياطات الدستورية والقانونية التي تمنع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وبشكل خاص ضمان الحياد السياسي للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتحديد أدوارهما، وإخضاعهما للقانون والمساءلة، وإتباعهما لمجلس دفاع وطني أعلى.
تحصين المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من القيام بدورها في حراسة مبدأ الفصل بين السلطات.
5- استقلال القضاء في سورية الجديدة
أ-سيحرص السوريون في دولتهم القادمة على تبني مبدأ استقلال القضاء وحمايته، باعتباره الشرط الأهم لضمان العدل، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وباعتباره الشرط الأهم لنهوض القضاء بمهامه بكفاءة ونزاهة وحياد. فلا يخضع إلا للدستور والقانون دون أي سلطة أخرى.
ب-ضمان استقلال القضاء من الناحيتين الإدارية والمالية يتطلب:
قواعد دستورية وقوانين واضحة ومفصلة ومتكاملة.
إعطاء حصانة دستورية خاصة للقواعد الدستورية التي تضمن استقلال القضاء.
إلحاق القضاء بمجلس قضاء أعلى مستقل عن السلطة التنفيذية بتركيبته وموارده وآليات عمله.
منع إنشاء هيئات قضائية استثنائية لا تخضع لشروط وقواعد القضاء العادي، بحيث يكون للقضاء العادي الولاية الشـاملة علـى جميـع المسائل ذات الطابـع القضائـي.
تمكين المحكمة الدستورية العليا من تأدية مهامها الضامنة لسموّ الدستور واحترامه، ولدستورية القوانين، والضامـنة للفصـل بيـن السـلطات والتـوازن بينهـا.
توفير الموارد الكافية لتمكينه من تأدية مهامه بطريقة سليمة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون ذلك.
6- نظام الحكم في سورية الجديدة
أ-سيكون على السوريين اختيار نظامهم الحاكم في سورية القادمة بعناية فائقة، باعتباره أحد أهم أركان النظام السياسي، وعموده الفقري الحامل، ويتوقف على اختياره مصير البلاد إلى حد بعيد.
ب-بسبب معاناتهم من حقبة استبداد قاسية، وارتباط تلك الحقبة بنظام الحكم الرئاسي، أصبح السوريون غالبيتهم يجنحون إلى الابتعاد عن نظام الحكم هذا. أما النظام البرلماني، بالرغم من أنه الأبعد عن تصنيع المستبدين لضعف موقع الرئاسة فيه والأكثر قدرة على تمثيل جميع الفئات وإشراكها في الحياة السياسية؛ فإنه لن يكون قادرًا على توفير الاستقرار ودعم حكومات كفؤة ومستقرة وقادرة على الإنجاز، بسبب ظروف البلاد عشية الانتقال، حيث الانقسام والاستقطاب المجتمعي، وحيث لا وجود لحياة سياسية وأحزاب قوية.
ت-لذلك، فالنظام المختلط/ شبه الرئاسي هو الخيار الأنسب لسورية القادمة، بسبب مرونته وقدرته على التكيف، وإمكانية صوغه بالشكل الذي يجنب البلاد عيوب النظامين البرلماني والرئاسي، وينتج حكومات كفؤة مستقرة وقادرة على الإنجاز، ويراعي في الوقت نفسه ظروف الحالة السورية وخصوصيتها. وسيبقى النظام المختلط ضروريًا بشكل خاص في سنوات الانتقال والتعافي، ريثما تترسخ الحياة السياسية والتقاليد الديمقراطية والمؤسسات القادرة على ضمان الاستقرار.
ث-يحتاج الأمر إلى اجتراح صياغة دستورية مفصلة على القياس السوري، تقوم على فهم عميق للواقع السوري من جانب، وللتجارب الدستورية العالمية المماثلة من جانب آخر.
ج-لا بد من العمل على نشر الوعي بين السوريين، حول هذا الموضوع المهم والمصيري، وإيصال كل ما يتصل به من سيناريوهات وأبعاد وتفاصيل مهمة، لتجنب الخيارات العاطفية غير المدروسة. ولا بد من إعداد دراسات مسؤولة حول نظام الحكم المناسب لسورية، تأخذ بعين الاعتبار ظروفها وشروطها الموضوعية عشية الانتقال. ولا بد من فتح النقاش العام حول الموضوع.
7- شكل الدولة في سورية الجديدة
أ-ستكون “اللامركزية الإدارية الموسّعة”، التي توفّر للبلديات والمجالس المحلية المنتخبة ديمقراطيًا صلاحيات واسعة يحددها دستور ديمقراطي، كما يحدد الدستور طبيعة العلاقة بينها وبين السلطة المركزية، هي الشكل الأنسب للدولة السورية الجديدة، لأنها توفر أعلى مستوى ممكن من الممارسة الديمقراطية، وأفضل مستوى ممكن من الكفاءة والمرونة في إدارة المناطق وتخصيص الموارد، بما يضمن مستوى أفضل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو الشكل الذي يستجيب لتطلعات السوريين جميعًا، ويراعي تنوعهم ويحترم رغباتهم وثقافاتهم، ويعزز انتماءهم الوطني.
ب-سيكون للإدارات المحلية أجهزتها التنفيذية، وموازناتها، ومواردها المالية الذاتية، ومشاريعها الاقتصادية، كي تتمكن من النهوض بمهامها الإدارية والاقتصادية والثقافية والخدمية، من دون أن يتعارض ذلك مع الأنظمة المالية والضريبية المركزية المرتبطة بالخزينة العامة.
ت-لا يجوز -بأي حال- المساس بوحدة الشعب السوري، ووحدة الأراضي السورية. ويجب الحفاظ، دستوريًا، على صلاحيات المؤسسات المركزية التي تمثل تلك الوحدة، خاصة في ميادين السياسية الخارجية والدفاع والأمن الوطني والعملة، وكل ما يتعلق بالمحافظة على هوية الدولة الوطنية، على أن تضطلع المحكمة الدستورية العليا بدورها في مراقبة توزيع السلطات بين المركز والأطراف، ومعالجة مشاكله.
8- معالجة الأزمة الطائفية
أ-لا بدّ للسوريين من العمل على اجتثاث شأفة الطائفية التي نمت وتجذرت، بفعل سياسات نظام الأسد وممارساته الطائفية، وطريقته في إدارة التنوع السوري، ثم بسبب فائض التحريض الطائفي الذي حصل بُعيد انطلاق الثورة، بفعل النظام من جانب[4]، وبعض الفصائل وجماعات الإسلام السياسي ذات الطابع الطائفي والمذهبي من جانب آخر[5].
ب-يجدر بالسوريين العمل على تطويق وتحجيم الأزمة الطائفية منذ الآن، ويمكنهم بشكل خاص القيام بما يلي:
عزل الخطاب الطائفي لدى النخب بشكل رئيس، وتنقيته من المفردات والمصطلحات الطائفية.
دعم الحوار، وتوسيع دائرته ليشمل المختلفين، بغية تجاوز الأسوار القائمة بينهم.
نشر الوعي بين الناس حول أخطار الطائفية ومآلاتها الكارثية على الوطن وجميع أبنائه. مع التركيز على التعليم ومناهج التعليم في المناطق التي يمكن العمل عليها في الداخل السوري وفي دول اللجوء.
طرح حطاب علماني ذكي وجديد ومختلف، متفهّم للثقافة والبيئة، يركز على المضمون، ويبتعد عن استفزاز المتدينين.
عدم تحميل كل أبناء الطائفة العلوية وزر الكارثة التي تسبب بها النظام، وعدم تحميل المسلمين السنّة وزر أعمال التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
تركيز الخطاب على مفهوم الهوية الوطنية السورية، مع التأكيد دائمًا على الانتماء الثقافي إلى الحضارتين العربية والإسلامية.
الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني، لقدرتها على اختراق المجتمع الأهلي والتأثير فيه، وقدرتها على التواصل مع فئات واسعة من الناس.
ت-بعد الانتقال السياسي، يجدر بالسوريين العمل على:
إيجاد منظومة قانونية (دستور وقوانين) حيادية تجاه الأديان والمذاهب وكل أنواع الأيديولوجيا، تجرّم الطائفية، وتمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي.
حيادية الدولة وفصل مؤسساتها عن أي انتماءات طائفية أو عرقية أو غيرها من انتماءات دون وطنية، بحيث تكون الدولة السورية منزوعة الصفات، دولة كل مواطنيها بدون تمييز.
السعي الدؤوب لتحقيق عدالة انتقالية في سورية، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لسحب فتيل الأزمة الطائفية وإعادة السلم الأهلي.
9- معالجة الأزمة القومية
أ-كما الحال في الأزمة الطائفية، فقد وصلت الأزمة القومية بين الجماعتين القوميتين العرب والكرد إلى مرحلة متقدمة وخطرة، خاصة على مستوى النخب السياسية والثقافية، والقوميين المتعصّبين من الطرفين، ويخشى مع استمرار الصراع وحالة الاستنقاع السياسي، واستمرار فعالية المحرضين، أن تذهب الأمور إلى مرحلة اللاعودة[6].
ب-على المعنيين من السوريين:
الإقرار بأن سورية بلد متعدد القوميات والطوائف، وأن جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات والفرص.
الاعتراف المتبادل بأخطاء الماضي في حال حصولها، والاعتذار عنها، لطيّ صفحة الماضي والتطلع للمستقبل المشترك.
مقاومة التعصب والتطرف ونبذ خطاب الكراهية، أيًّا كان مصدره، والقطع مع لغة العنف والتخوين، وتبني خطاب وطني هادئ منفتح تصالحي إيجابي.
النظر والتعامل مع القضية الكردية، باعتبارها جزءًا رئيسًا من المسألة الوطنية والديمقراطية في سورية. واعتبار أن الحلّ النهائي لمسائل التنوع، بكل أشكالها، مع تحويلها إلى عامل ثراء وتقدم، هو قيام دولة وطنية، ديمقراطية، لا مركزية إدارية، علمانية، تقدّس مبدأ المواطنة المتساوية.
ت-الكرد السوريون جزءٌ أصيل من الشعب السوري، ولهم تاريخهم وثقافتهم الخاصة الواجبة الاحترام، كما كل ثقافات الآخرين، وقد ألحق بهم نظام البعث/ الأسد ظلمًا إضافيًا.
ث-ستُعالج الأزمة القومية في سورية المقبلة عبر:
دستور ديمقراطي يُقرّ بالتعددية والمواطنة المتساوية واللامركزية الإدارية الموسّعة، ويضمن الحقوق الثقافية للجميع.
التوافق على مبادئ فوق دستورية تطمئن الجميع.
معالجة القوانين والإجراءات التمييزية الجائرة بحق الكرد.
10- العدالة الانتقالية لأجل سورية الجديدة
أ-العدالة الانتقالية ضرورة ماسّة من أجل تعافي سورية، ورأب الصدوع المجتمعية العميقة التي قامت بين السوريين، بعد هذه التركة الثقيلة من الجرائم والانتهاكات التي خلفتها الحقبة السابقة، ومن أجل تحقيق المصالحات ومد جسور الثقة مجددًا بين السوريين، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وإعادة البناء والتجاوز نحو المستقبل.
ب-ومطلب العدالة الانتقالية يجب أن يبقى ضروريًا وراهنًا، مهما امتد الزمن، فالجراح ستبقى محفورة في الوجدان الجمعي، وستتناقلها الأجيال، إذا لم تجد لها تسويات ملائمة.
ت-سيكون على السوريين اجتراح مسار عدالة انتقالية خاص بهم، في ضوء الظروف والعوامل وموازين القوى المتحكمة، على أن يتم إيلاء الأمور التالية اهتمامًا خاصًا لضمان مسار عدالة انتقالية أكثر نجاحًا وفعالية:
التركيز على دور الضحايا وذويهم وتنظيمهم لممارسة الضغط الدائم على السلطات لتفعيل إجراءات العدالة الانتقالية، مهما امتد الزمن.
التركيز على منظمات المجتمع المدني لحمل المشروع على الدوام والنضال لتحقيقه، باعتبار أن هذه المنظمات مستقلة وخارج إطار التسويات السياسية وما تفرضه من حلول على السلطات الرسمية.
إشراك المرأة بشكل فعال في كل محطات وجوانب العدالة الانتقالية.
الضغط على السياسيين والمفاوضين بكل الوسائل للتمسك بموضوع العدالة الانتقالية.
تشكيل مجموعات ضغط فعالة من السوريين المقيمين في الدول المؤثرة والفاعلة في الملف السوري، لدعم مسار العدالة الانتقالية في سورية.
دراسة تجارب الدول الأخرى، الناجحة والفاشلة.
فصل مسار العدالة الانتقالية عن مسار التسوية السياسية.
الحرص على ألا تتحول العدالة الانتقالية إلى أداة للثأر والانتقام، وعلى نشر ثقافة الصفح والتسامح كعامل مهم في التجاوز والتعافي.
ث-يجدر بالسوريين الاستعداد لمرحلة العدالة الانتقالية، وتحسين فرص واحتمالات حدوثها، عبر عدد من الإجراءات، منها الاهتمام بالتوثيق، وإعداد الدراسات والمشاريع اللازمة، وبرامج التوعية والتثقيف.
11- المواطنة المتساوية في سورية الجديدة[7]
أ-تُعتبر المواطنة المتساوية[8] حجرَ الأساس في بناء وتعزيز شعور الفرد بانتمائه إلى وطنه، وفي بناء الهوية الوطنية المشتركة، كما تعتبر الإطار الأمثل لمعالجة قضايا التعدد والاختلاف في بلد متعدد متنوع كسورية. ولذلك فإن حاجة السوريين إليها مضاعفة لسببين: الأول هو هذا التنوع الذي يشكل نسيج المجتمع السوري، والثاني هو هذه الحالة المتقدمة من التمزق المجتمعي التي وصلنا إليها بعد هذه الحرب المأساوية، وبعد هذه العقود الخمسة التي حكم فيها نظام الأسد البلاد، وفعل خلالها كل ما يدمر مرتكزات المواطنة، ومقومات الاجتماع الوطني والحياة الوطنية المشتركة، بدءًا بالتمييز والتهميش والإقصاء، مرورًا بإلغاء الحياة السياسية ومنع تشكل مجتمع مدني فاعل، وبتعميم الفساد والإفساد، وصولًا إلى تطييف المجتمع والإدارة الأمنية للتنوع السوري…
ب-لذلك، لا بدّ أن تقوم الدولة السورية القادمة على قيم المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، بغض النظر عن جنسهم ودينهم وقوميتهم وانتماءاتهم الأخرى.
ت-إن استيفاء أركان المواطنة المتساوية في سورية القادمة سيتطلب تحقق مروحة واسعة من الشروط، تكاد تشمل أهم شروط قيام الدولة الوطنية الحديثة، منها وجود منظومة متكاملة من حقوق الحريات، ومنها سيادة القانون ليكون فوق الجميع، ومنها نزاهة واستقلال القضاء لضمان الحقوق والحريات والمساواة بين الناس، ومنها الحياة السياسية السليمة بما تتطلبه من أحزاب وانتخابات وتداول للسلطة… ما يسمح لنا بالقول إنّ المواطنة الحقيقية لا تستوفي أركانها وشروطها إلا في دولة ديمقراطية من جانب، ومحايدة تجاه الأديان والمذاهب والمعتقدات من جانب آخر. والعكس صحيح، فلا ديمقراطية حقيقية ولا حيادية حقيقية دون مواطنة متساوية.
ث-سيكون ضعف الشعور بالانتماء الوطني لدى السوريين، بسبب الاستبداد المزمن ومآسي السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، من أبرز المعوقات التي تعترض مساعي السوريين في ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية في سورية الجديدة، إضافةً إلى عقبات أخرى، كالتخلف الاجتماعي، واستمرار حالة التمييز بين الرجل والمرأة بسبب المنظومة الثقافية السائدة، وتعدد قوانين الأحوال الشخصية، وعدم وجود قانون أحوال شخصية مدني يلجأ إليه الراغبون، وعدم حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات.
ج-على السوريين العمل، منذ الآن ما أمكن، وفي المستقبل، على نشر الوعي بقيم المواطنة على أوسع نطاق، والتركيز على المؤسسات التعليمية والتربوية، باعتبار أن المدرسة هي مصنع المواطنة الأول.
12- علمانية الدولة في سورية الجديدة [9]
أ-العلمانية خيار ضروري لإنقاذ سورية ممّا هي فيه، ولبقائها دولة موحدة، ولتوفير شروط استقرارها وقدرتها على النهوض والتقدم، لسببن رئيسين: الأول هو حالة التعدد والتنوع الديني والإثني التي تميز سورية، ما يستدعي مؤسسات وقوانين وممارسات لا تميز بين الأديان والمعتقدات. والثاني طمأنة الجماعات السورية المختلفة إلى مستقبلها، من بعد الرضوض الشديدة التي أصابت الاجتماع الوطني جراء حقبة الاستبداد، خاصة بمرحلتها الأخيرة الدامية.
ب-ستكون علمانية الدولة السورية القادمة علمانية ليّنة، تناسب السوريين، وتتلاءم مع بيئتهم وثقافتهم، يتم اجتراحها انطلاقًا من فهم معوقات العلمانية في مجتمع يؤدي فيه الدين دورًا مهمًّا، وتعاني فيه العلمانية من سوء الفهم والسمعة والمواقف السلبية المسبقة. والعلمانية اللينة المطلوبة تعني أن يقتصر تطبيق العلمانية على مستوى شؤون الحكم ومؤسسات الدولة فقط، وليس على مستوى المجال العام، فيكون للناس حرية ممارسة شعائرهم والتعبير عن معتقداتهم في الفضاء العام، بالطريقة التي تناسبهم، وبما لا يخالف القانون، بل من واجب الدولة حمايتهم واحترامهم.
ت-تقتضي العلمانية المنشودة تلازم مفهوم العلمانية وتكامله مع مفهومي المواطنة والديمقراطية. فدولة المواطنة لا بد أن تكون علمانية، والعكس صحيح، لأن المواطنة تفترض أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع. والنظام الديمقراطي لا بد أن يكون علمانيًا، والعكس صحيح، لأن الديمقراطية لا تقوم دون حيادية الدولة تجاه جميع الأديان والمعتقدات، والعلمانية لا تقوم دون بيئة ديمقراطية، فالاستبداد لا يمكن أن يكون حياديًا بحال من الأحوال. وتبقى الديمقراطية هي الأساس، وهي الإطار العام الذي يصوغ الناس فيه نظامهم ومؤسساتهم.
ث-يجب ألا يتضمن الدستور والقانون أي نصوص تشير إلى التمايز بين الجماعات السورية، ويجب أن تكون التشريعات وضعية. والدولة السورية الجديدة يجب أن تكون منزوعة الصفات، لأنها فضاء مشترك لا يجوز احتكاره من قبل أي جماعة، مهما كانت كبيرة، لأن في ذلك إقصاء لجماعات أخرى.
13- النموذج الاقتصادي والاجتماعي في سورية الجديدة
أ-سيجمع النظام الاقتصادي في سورية القادمة بين الكفاءة الإنتاجية، والعدالة في توزيع الدخول، والعدالة الاجتماعية عمومًا، وذلك من أجل امتلاك نظام اقتصادي ناجح ومستقر، يحقق التوازن بين المحافظة على قدرة وكفاءة الاقتصاد من جانب، وعلى مستوى لائق من العدالة في توزيع الدخول والثروات من جانب آخر، وعلى مستوى لائق أيضًا من الرعاية والضمانات الاجتماعية من جانب ثالث[10]. وهذا التوازن المذكور أعلاه لا يتحقق إلا عبر:
–نظام اقتصادي يقوم على اقتصاد السوق الحرّ المنظّم، بما يعنيه من حرية التملك والاستثمار والتعاقد واحترام قوانين العرض والطلب.
–الالتزام بشرطَي العدالة في توزيع الدخول، والبعد الاجتماعي والإنساني.
-تحقيق التوازن التنموي الإقليمي بين المناطق والمحافظات السورية، وتوزيع الاستثمارات والخدمات ومشاريع التنمية بشكل متوازن، ووفق أسس علمية، مما يزيل الإجحاف الذي لحق بالمناطق الشرقية والطرفية المهمشة، بما ينمي روابطهم الوطنية تجاه بلدهم، ويساهم في تمتين ترابط الاجتماع الوطني السوري.
ب-سيبقى الاستقرار السياسي هشًا، وتبقى الديمقراطية التي ينشدها السوريون لمستقبلهم ضعيفة ومهدَّدة، ما لم يتحقق مستوى مقبول من القدرة الإنتاجية المرتفعة مع تحقيق العدالة الاقتصادية، سواء في توزيع مشاريع التنمية بين المناطق والأقاليم، أو في توزيع الدخول والثروات بين الناس.
ت-يقتضي تحقق شرط العدالة في توزيع الدخول والثروات في اقتصاد السوق الحر:
وضع سياسات عادلة للأجور والرواتب والتعويضات، تربط الأجر بالإنتاج وبمستوى المعيشة أيضًا. وهذه تتطلّب حمايتها بقواعد دستورية من جانب، وقوى مجتمعية تدافع عنها من جانب آخر.
توسيع قاعدة ملكية رؤوس الأموال، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة توزيع الأرباح، وذلك عبر تطبيق سياسات تشجع وتدعم الملكية الصغيرة والملكية الأسرية والملكية المشتركة والملكية التعاونية والمساهمة، على أن تخضع جميعها لقواعد السوق والمنافسة، دون أي منع أو تقييد للملكيات والمشاريع الفردية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وأيضًا تطبيق سياسات تشجع رجال الأعمال وأصحاب الشركات على إشراك العاملين بحصّة أو أسهم في رأس المال. كل هذا سيؤدي إلى توسيع قاعدة الأفراد المالكين للأسهم والحصص، والمستفيدين من توزيع الأرباح، مما يسهم في تحسين صورة العدالة الاجتماعية.
ث-أما البعد الاجتماعي والإنساني في نظام اقتصاد السوق الحر في سورية القادمة، فيتحقق عبر:
منظومة قانونية (دستور وقوانين وأنظمة) تنظم وتضمن حقوق العاملين وحياتهم الكريمة أثناء العمل وأثناء التقاعد.
تطوير سياسات مالية وضريبية وتجارية تشجع المؤسسات الاقتصادية على لعب أدوار مجتمعية، ودعم فعاليات مجتمعية، كالجمعيات والمشاريع ذات الطابع الخيري أو الثقافي أو العلمي أو التعليمي أو الطبي أو البيئي.
ج-تحقيق هذا النموذج الاقتصادي المنتج والعادل يحتاج إلى دولة ذكية، سيكون على السوريين اجتراحها. وهذه الدولة الذكية هي غير الدولة المهيمنة وفق النموذج الاشتراكي، التي تقضي على روح المبادرة والقدرات الإبداعية لدى الفرد والمجتمع، وهي غير الدولة النحيلة وفق النموذج الليبيرالي، التي تعلي مصالح أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على مصالح وطموحات باقي أفراد المجتمع. بل هي الدولة الحريصة والقادرة على:
اعتماد سياسات تحفز المبادرة الابتكار والاستثمار، وتدفع مسارات النمو والتنمية، مع حد أدنى من التدخل لضبط عمل السوق الحر وتنظيمه، وإصلاح الخلل الذي قد يحدثه.
إقامة نظام ضمان اجتماعي يوفر الطبابة والتعليم والسكن والتقاعد والحياة الكريمة للجميع.
المساهمة بشكل مباشر، ودون احتكار، في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يضمن عدم حدوث خلل في عمل هذه القطاعات نتيجة تركها لأصحاب رؤوس الأموال.
اعتماد نظام ضريبي تصاعدي عادل، وسياسات أجور عادلة، تربط الأجر بالإنتاج، وبالقدرة الشرائية ومعدلات التضخم.
ح-أما بخصوص العدالة المناطقية، بين المناطق السورية، فلا بد من العمل على:
اعتماد سياسات وخطط تنمية إقليمية عادلة ومتوازنة بين جميع الأقاليم والمناطق، دون إهمال أو تهميش لأي منطقة.
تخصيص المناطق التي هُمِّشت وظُلمَت، خلال حقبة البعث/ الأسد، وربما قبلها، ببرامج تنمية تمييزية مؤقتة لتعويضها عن بعض ما فاتها، وتحسين مشاعر الرضى لدى أبنائها.
ستمنح صلاحيات اقتصادية للإدارات المحلية، وفق نموذج “اللامركزية الإدارية الموسعة”، بما يتيح لأبناء المناطق ومجالسهم المنتخبة المشاركة الفعالة في إدارة الجانب الاقتصادي لمناطقهم، وبما يتيح تخصيصًا عادلًا للموارد.
خ-إن الشرط الضروري، من أجل ضمان العدالة الاقتصادية المنشودة في سورية القادمة، هو قوة المجتمع الواعي بحقوقه. وتقوم هذه القوة على حوامل عديدة: أحزاب سياسية تتبنى هذه القضية وتدخلها في برامجها؛ ونقابات عمالية قوية وقادرة على التفاوض الندّي مع أصحاب الأعمال؛ وجامعات تُدخل هذه النظريات والسياسات والتجارب في مناهجها التعليمية؛ ومثقفون ومفكرون وكتاب وباحثون طليعيون ومراكز أبحاث يتبنون هذه القضية في كتاباتهم ونظرياتهم ودراساتهم؛ ووسائل إعلام تتبنى وتروج لهذا النموذج الاقتصادي الكفؤ والعادل.
14- منظمات المجتمع المدني في سورية الجديد
أ-لمنظّمات المجتمع المدني دور بالغ الأهمية، في حاضر سورية ومستقبلها، وذلك لمهامها الأساسية المعروفة والراسخة في المجتمعات المتحضرة، ولقدرتها على حمل فكرة التغيير، وعلى تحدي الظروف الصعبة والمشاكل المستعصية، كالتي يعيشها السوريون الآن، ويتوقع أن ترافقهم في مستقبلهم القريب[11].
ب-سيكون على منظمات المجتمع المدني السورية المساهمة، إلى جانب مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، بالنهوض بمهام كثيرة من أهمها:
إعادة بناء الثقة بين السوريين، وإطفاء الحرائق القائمة بينهم على غير صعيد. والمساهمة في تعزيز الثقة والتقارب والتصالح بين السوريين.
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقيم المواطنة والعلمنة وسيادة القانون، ونشر التوعية بين الناس بهذه الموضوعات وتعزيزها.
لعب دور المراقب الشعبي على أداء السلطات المنتخبة على مختلف المستويات.
حمل ملفات المعتقلين والعدالة الانتقالية مهما طال الزمن، ودعم برنامج العدالة الانتقالية.
ت-على الدولة السورية القادمة تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني بكل أشكالها، وتوفير أسباب نجاحها، وذلك عن طريق:
-نصوص دستورية وقانونية تحدد أدوارها وتوفر لها الاستقلالية والحماية والدعم.
-توفير الدعم المادي والمعنوي غير المثقل بشروط لها.
-على منظمات المجتمع المدني ترسيخ الحياة الديمقراطية داخل منظماتها، واعتماد معايير الإدارة العلمية والشفافية والمحاسبة، والاعتماد على العمل التطوعي.
15- التربية والتعليم في سورية الجديدة
أ-سيحرص السوريون على إعطاء التعليم بكلّ مراحله أكبر اهتمام ورعاية ممكنين، مدركين أن الاستثمار به هو أفضلُ وأهمّ ما يمكن لهم عمله من أجل نهوض البلاد وتقدمها، فضلًا عن أن المدارس والمؤسسات التعليمية هي المكان الأول لترسيخ وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والديمقراطية وحقوق الإنسان.. والسوريون بأمس الحاجة إلى هذه القيم[12].
ب-سيتم تكريس الاهتمام بالتعليم عبر:
-تبني مبدأ ديمقراطية التعليم والتربية للجميع دون تمييز.
-نصوص قانونية ودستورية وبرامج حكومية وخطط طموحة وموازنات كافية.
-إيلاء المعلمين اهتمامًا خاصًا، سواء لجهة تأهيلهم أو تأمين حياة كريمة لائقة بهم، باعتبارهم أساس نجاح العملية التعليمية.
-تجهيز المدارس بكل ما يلزم من تجهيزات تعليم حديثة.
-إبعاد التعليم عن كل أنواع الأيديولوجيا، وعن كل ما يتعارض مع مفاهيم المواطنة والعيش المشترك. والتركيز على خلق أجيال تتمتع بتفكير علمي نقدي.
-جعل التعليم إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الإعدادية، وإتاحة التعليم المجاني بمراحله كافة لجميع السوريين.
-الاهتمام بالتعليم التقني.
-تشجيع القطاعين التعاوني والخاص للاستثمار في المشاريع التعليمية، والاهتمام بتنويع أنظمة التعليم، وبالنظم التعليمية الهجينة، على أن تبقى خاضعة لخطط الدولة ومناهجها ورقابتها.
-الاهتمام بالتربية التعويضية للسوريين الذين حرمتهم ظروف الصراع من التعليم.
ت-ستهتم مناهج التعليم بتدريس الأخلاق وقيم المواطنة والوطنية والحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحيادية الدولة، وكل ما من شأنه تنشئة أجيال قادرة على بناء دولة حديثة متقدمة متصالحة مع العصر.
خاتمة
تطمح هذه الوثيقة (مشروع وثيقة توافقات وطنية) المستخلصة من مخرجات برنامج الحوار الوطني إلى أن تُشكِّل أساسًا متينًا لتوافق طيف واسع من السوريين، وخروجهم من حالة الشرذمة والتشتت إلى حالة العمل المشترك الواسع القادر على الفعل والتأثير في مصير بلادهم وأهلهم. كما تطمح إلى أن تُشكل أساسًا متينًا لمشروع وطني متكامل، يساعد السوريين في الخروج من محنتهم، وفي بلسمة جراحهم، وتجاوز ماضيهم الأليم القريب والبعيد، ووضع أسس دولتهم الحديثة، دولة الحق والقانون والعدالة والحريات، والمواطنة، والعلم والمؤسسات.
ولا يكتمل هذا الجهد إلا عبر إغنائه المستمر بمزيد من النقاش، بين السوريين على كل المستويات، وبتزايد أعداد الداعمين له من كل الأطياف.
[1] يجدر بنا التنويه إلى أن المشارَكة في النقاش لا تعني موافقة كل مشارك على كل ما جاء في الوثيقة بتفاصيله دون أي ملاحظة، وأن وضع الأسماء هنا يتم بموافقة أصحابها فقط.
[2] من أبرز الحقوق الواردة في الشرعة الدولية: الحق في الحياة – الحق في الأمان – الحق في حرية الرأي والتعبير – الحق في حرية الفكر والوجدان والاعتقاد – الحق في المساواة وعدم التمييز – الحق في مستوى معيشي وصحي لائق – الحق في التربية والتعليم – الحق في التجمّع السلمي – الحق في العمل بشروط عادلة ومرضية – الحق في تشكيل و/أو الانتساب إلى النقابات والجمعيات – الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة – حقوق الأطفال والمراهقين والمرأة في المساعدة والدعم….
[3] يقوم المبدأ على الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان قدر من الاستقلالية لكل منها، بما يسمح لها بمباشرة مهامها بحرية ودون وصاية أو ضغوط من السلطات الأخرى، ويحدد الدستور حدود الفصل بين السلطات، وينظم العلاقة والتوازن بينها، ويمنع تغول إحداها على الأخرى.
[4] مع ذلك، لا يمكن اعتبار نظام الأسد نظامًا للطائفة العلوية، إنما هو وظّف الطائفة العلوية في الصراع السياسي، وربَط مصيرها بمصيره، واستخدمها وقودًا في مشروعه.
[5] كان للإسلام السياسي دور مهم في تسعير الأزمة الطائفية، بسبب تركيزه على الفصائل الدينية والتعبيرات الدينية في صراعه مع النظام، ما ساهم في دفع معظم العلويين إلى الالتصاق بالسلطة والاستماتة في الدفاع عنها، خوفًا من المصير المخيف الذي يعتقدون أنه ينتظرهم بعد رحيله، وما ساهم أيضًا في اقتراب بعض أبناء الأقليات الدينية من النظام، أو وقوف معظمهم على الحياد خوفًا من المجهول.
[6] يتحمّل حزب البعث ونظام الأسد القسط الأكبر من المسؤولية عن نشوء الأزمة القومية بين العرب والكرد واستفحالها. وكذلك يتحمّل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومن خلفه حزب العمال الكردستاني PKK قسطًا كبيرًا من المسؤولية، ويتحمّل غلاة القوميين من الطرفين قسطًا من المسؤولية أيضًا.
[7] المواطنة هي تلك العلاقة التي تربط الفرد بالدولة من ناحية، وبسائر المجتمع من ناحية أخرى، وهي علاقة سياسية قانونية بين الفرد والمجتمع السياسي الذي ينتمي إليه، والذي ستحكمه جملة من القوانين والأنظمة التي ينبغي عليه احترامها، وينبغي عليها بالمقابل حمايته ومنحه ما يستحق من امتيازات وحقوق.
[8] تقوم المواطنة على ثلاثة أركان: الأول هو الجنسية السورية، حيث يكون لجميع المواطنين والمواطنات الحق في اكتساب جنسية بلدهم ومنحها لأبنائهم ولزوجاتهم وأزواجهم، وما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات وامتيازات. والثاني هو المساواة، حيث يتساوى جميع السوريين والسوريات في تلك الحقوق والواجبات والامتيازات، أمام القانون والمحاكم ومؤسسات الدولة. والثالث هو حق جميع السوريين في المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على قدم المساواة، وشغل الوظائف العامّة كافة، ومن ضمنها منصب رئيس الجمهورية.
[9] العلمانية تعني فصل السلطة السياسية ومؤسسات الدولة عن الدين والمؤسسة الدينية. فلا يتدخل ممثلو الدين بشؤون السياسة والحكم، ولا تتدخل السلطة السياسية ومؤسسات الدولة بشؤون الدين، بل تبقى حيادية تجاه الأديان والمعتقدات، مع التزامها بحمايتها جميعًا، وتوفير الشروط اللازمة ليمارس أتباعها طقوسهم وشعائرهم وعباداتهم بحرية وأمان.
[10] اتسمت إدارة الاقتصاد في سورية بما اتسمت به إدارة البلاد عمومًا، من ضعف وفساد، وتقديم الولاء على الكفاءة، وغياب أيّ نوع من الرقابة البرلمانية أو السياسية أو المجتمعية أو الإعلامية، ممّا أضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري. وقد ترافق ذلك مع تضخّم أجهزة الدولة البيروقراطية، وتضخم الجيش والأجهزة الأمنية والإنفاق عليها، ما أدّى إلى تراجع الوضع الاقتصادي في سورية، وتدهور الخدمات، وانخفاض دخول العاملين بأجر، وتراجع القدرة الشرائية لغالبية السوريين، وارتفاع معدلات الفقر، وازدياد التفاوت في الثروة بين مجموعة فاسدة فاحشة الثراء مرتبطة بالسلطة، وبين غالبية الناس. كما اتسمت باختلال التوازن التنموي بين المناطق، مع إهمال منطقة الجزيرة والمناطق الشرقية والبادية التي تنتج النفط والغاز والقمح والأقطان والفوسفات.
[11] تم تغييب منظمات المجتمع المدني في مرحلة الأسد وإلحاقها بالنظام، خاصة بعد الأحداث الدامية في مطلع الثمانينيات، حيث تم حل النقابات، آخر منظمات المجتمع المدني، ثم أعيدَ تشكيلها لتكون جزءًا من أجهزة النظام. وبعد الانتفاضة الشعبية في العام 2011، ظهرت منظمات المجتمع المدني السورية بكثافة، بعضها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ومعظمها في دول اللجوء، واستطاعت، رغم ضعف إمكاناتها وقلة خبرتها، أن تنهض بأدوار مهمة، خاصة على صعيد تمكين السوريين والسوريات من مسائل مهمة كانت مغيّبة، كالمواطنة. لكن مستوى أدائها وفعاليتها بقي دون الطموح بكثير، بسبب مشكلات وصعوبات عديدة، مثل غياب التمويل الذاتي أو الوطني غير المشروط، وفقدانها للاستقلالية. كما عانت الأمراضَ التي اختبرناها في أحزاب وتشكيلات المعارضة، كالانقسام والتعصّب، وتغليب المصالح الشخصية، وغياب الحياة الديمقراطية، وغياب الإدارة العلمية والمؤسساتية، وغياب مهارات الحوار وإدارة الاختلاف.
[12] كان التعليم متردّيًا في حقبة البعث/ الأسد إلى حد بعيد، حيث كان مؤدلجًا، يقوم على الإملاء والتلقين، وهدفه الأول هو ضمان أجيال تابعة وموالية، وتعبئة أفراد المجتمع وضبطهم. وكانت الثقافة القومية هي البديل عن الثقافة الوطنية وعن ثقافة المواطنة. وكان التعليم مفصولًا عن الواقع وعن سوق العمل، ينخره الفساد. وكان المعلّم مسحوقًا ومهمشًا. وحالة التعليم الآن ليست أفضل، بل أسوأ على كل المستويات: ضعف الإمكانات، وحجم الاستيعاب، ونسب التسرّب من المدارس، ولا سيما مع وجود مناهج مؤدلجة مختلفة ومتضاربة بين منطقة نفوذ وأخرى، تستخدمها سلطات الأمر الواقع للتعبئة وخدمة مشاريعها. ما يعني أنّ هذه المناهج أصبحت مِعول هدم إضافي للنسيج الاجتماعي السوري المتهتك أصلًا، تساهم في تكريس الانقسام، ورفع الحواجز بين السوريين.
—————————-
ملاحظات أولية على “مشروع وثيقة توافقات وطنية”/ طارق عزيزة
نشر مركز حرمون للدراسات المعاصرة وثيقةً، بعنوان “مشروع وثيقة توافقات وطنية”، استندت إلى خلاصة مخرجات عمل مشروع حوار وطني أطلقه المركز، استمر لأكثر من عام، وشارك فيه مئات السوريات والسوريين من مشارب فكرية وسياسية وانتماءات دينية وقومية متنوّعة، سواء بصورة مباشرة من خلال جلسات الحوار الأساسية، أو غير مباشرة عند مناقشة تقارير الجلسات. نوقش “12 موضوعًا رئيسًا ذا علاقة بإعادة بناء الدولة السورية، من الموضوعات التي يوجد حولها تباينات كبيرة أو صغيرة، بين التيّارات الرئيسة في سورية، وغاية الحوار إبراز نقاط الالتقاء والافتراق وممكنات جسر الهوية والوصول إلى توافقات في الرؤى”، وفق وصف القائمين على المشروع.
شملت الموضوعات القواعد الدستورية المحصنة، نظام الحكم وشكل الدولة وعلمانيتها، المواطَنة المتساوية، العدالة الانتقالية، الحقوق والحريات، الأزمة الطائفية والأزمة القومية، التعليم والتربية، النموذج الاقتصادي، ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن المبادئ العامة، سيادة القانون، الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء. وإذ تُعرض الوثيقة الآن على النقاش العام، وبعد تثمين جهد فريق المشروع والمشاركات والمشاركين فيه كافّة، تأتي هذه الملاحظات أو التعليقات الأولية على بعض ما جاء في مشروع الوثيقة، سعيًا إلى المساهمة في تطوير مضمونها.
على الرغم من أنّ الوثيقة صيغت ضمن رؤية ذات أفق مستقبلي، فإنّ إغفالها الخوض في عدد من المعطيات الإشكالية الراهنة والسابقة على مرحلة الشروع ببناء “سورية الجديدة”، شكّل قصورًا يحتاج إلى معالجة، نظرًا لما ينطوي عليه الموقف إزاء تلك المعطيات من خلافات عميقة في الرؤى والمواقف، مما يتطلّب السعي إلى إيجاد توافقات حولها.
إنّ “التسوية السياسية” المتعثرة، وما قد ينتج عن استئنافها ونجاحها، وكذلك موضوع استمرار وجود القوى الأجنبية المنتشرة في سورية، هما عاملان مؤثّران في إمكانية العمل مستقبلًا على إيجاد السبل الكفيلة بإنجاز المواضيع والمحاور التي تناولتها الوثيقة. كما أنّ مصير الجيش وأجهزة المخابرات الحالية، وكذلك الميليشيات المسلّحة، الموالية منها والمعارضة على حد سواء، هي مواضيع بالغة الأهمية لم تتطرّق إليها الوثيقة، وتحتاج إلى إيجاد “توافقات وطنية” في شأنها أيضًا، فالمقاربات متباينة عند مناقشة هذه الأمور، ونتائج السيناريوهات المحتملة مختلفة: حلّ الجيش والأجهزة الأمنية يختلف عن إعادة هيكلتهما، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها شيء، ودمج عناصرها وأسلحتهم في الجيش والشرطة شيء آخر. وبالتالي، سيكون من المفيد عقد مزيد من جلسات الحوار لمناقشة الموقف من هذه المسائل، أملًا في التوصل إلى توافقات وتضمينها في الوثيقة، نظرًا إلى تأثيرها البالغ على مجمل المواضيع التي ينشغل بها المشروع.
جرت الإشارة في فقرة “القواعد الدستورية المحصنة التي تحتاجها سورية” (ص7)، إلى وجوب اختيار هذه القواعد وفق “معايير دقيقة ومدروسة”، وفي هذا السياق، وردت عبارة عن قابلية القواعد الدستورية المحصنة “للتجميد، بحيث لا تصطدم بحركة المجتمع وحاجته إلى التطور” (ص8). تبدو العبارة ملتبسة أو غير دقيقة، فالقواعد هذه إما أن تبقى مصونة ومتمتعة بحصانة استثنائية ضدّ التعديل إلا بشروط شديدة الصعوبة، وفق ما جاء في الفقرة نفسها، أو أن تنتفي الحاجة إليها مستقبلًا، حين تبلغ سورية درجة من التطور السياسي والدستوري والقانوني، على صعيد الدولة والمجتمع، بحيث لا يعود هناك سبب لوجودها. أمّا فكرة “التجميد” وما توحي به من وضع مؤقت أو عارض، فهي لا تنسجم مع علّة وجود قواعد دستورية محصنة ودورها.
عند الحديث عن “سيادة القانون في سورية الجديدة” (ص9)، ورد بند بشأن “تحديد دور ووظائف مؤسستي الأمن والجيش، وإخضاعهما للقانون والمساءلة، ولمجلس مستقل عن الرئاسة، وضمان حيادهما السياسي”، وهنا ربما تجدر إضافة ما يفيد بأن ذلك يكون بموجب نص دستوري صريح. وجاء في البند الذي يليه “تكريس مبدأ دستوري يقضي بسمو الاتفاقات والمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية”، وهنا تخبرنا التجربة السورية في ظل الاستبداد أنه كثيرًا ما جرى التوقيع على اتفاقيات دولية، لكن من دون المصادقة عليها، أو المصادقة مع التحفظ على مواد أساسية فيها مما يبطل فاعليتها ويفرغها من مضمونها. إنها مشكلة يجب أن تُلحَظ في هذا المبدأ الدستوري، وإلا فلن يكون فعالًا أو ذا قيمة.
تحت عنوان “الحقوق والحريات في سورية الجديدة” (ص10)، تعلن الوثيقة أنّ الدولة السورية القادمة “تتبنى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوثائقها الثلاث، وتعمل على تكريسها دستوريًا وقانونيًا، باعتبارها خلاصة وذروة ما أنتجته الحضارة البشرية في مجال حقوق الإنسان عبر تاريخها، وباعتبارها منظومة متكاملة لحماية الأفراد وتكريس حقوقهم وحرياتهم وضمانها”. يُقصَد بالوثائق الثلاث التي تشكّل “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966). ويُعَدّ تبنّي هذه المواثيق أساسًا لا غنى عنه لبناء نظام ديمقراطي عصري يصون كرامة الإنسان وحقوقه، إلّا أنّ منظومة حقوق الإنسان تطوّرت باطّراد، وبات هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تفصّل في الحقوق المنصوص عنها في الوثائق الثلاث المشار إليها، مثل اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء (1979)، واتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، فضلًا عن نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية (1998). ومن ثم، ينبغي عدم الاكتفاء بذكر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإشارة إلى اتفاقيات أخرى ذات صلة، ويمكن ذكر بعضها كأمثلة ضمن هامش.
خصصت الوثيقة فقرة لموضوع “العدالة الانتقالية من أجل سورية الجديدة” (ص18)، لكنّها جاءت عمومية للغاية، تقتصر على تأكيد ضرورة العدالة الانتقالية وحاجة سورية الماسّة إليها. وبهذا، لم تقدّم الوثيقة أي إضافة لمن لا فكرة لديه عن “العدالة الإنتقالية” من القرّاء، فهي ليست عنصرًا واحدًا أو عمليّة واحدة، وحريٌّ بالوثيقة أن تشير إلى مسارات العدالة الانتقالية المترابطة (منها: محاسبة الجناة، كشف الحقائق، التعويض وجبر الضرر، إحياء الذكرى.. إلخ)، ولو على سبيل التعداد.
في فقرة “علمانية الدولة السورية” (ص21)، وردت عبارة تفيد بأنّ “العلمانية اللينة” التي تتحدث عنها الوثيقة “تعني أن يقتصر تطبيق العلمانية على مستوى شؤون الحكم ومؤسسات الدولة فقط”، وهنا ينهض السؤال: كيف سيكون النظام السياسي علمانيًا، تتكامل فيه الديمقراطية والمواطنة والعلمانية، ما لم تكن القوانين ومناهج التعليم علمانية أيضًا؟ علمًا أنّ الوثيقة، أكّدت في فقرة “التربية والتعليم في سورية الجديدة” (ص26)، أنّ “المؤسسات التعليمية هي المكان الأول لترسيخ وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والديمقراطية وحقوق الإنسان.. والسوريون بأمس الحاجة إلى هذه القيم”، وهذا يتطلّب نظامًا تعليميًا علمانيًا محايدًا على المستوى الوطني. لذا، لا بد من صيغة تجنّب الوثيقة الوقوع في هذا التناقض، الذي يسبّبه حصر العلمانية في السطح السياسي، وإغفال مستوياتها التأسيسية في المؤسسات التربوية والتعليمية. يمكن أن يبقى التعليم الديني اختياريًا، على نحوِ ما أشير في فقرة “الحقوق والحريات في سورية الجديدة” (ص12)، عن إمكانية إصدار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية شامل للسوريين جميعًا، وترك الخيار لمن يرغب في اتباع قوانين الأحوال الشخصية المستمدّة من المرجعيات الدينية.
هذه بعض النقاط التي يؤمل أن يكون لها أثر إيجابي في تطوير الوثيقة. ويبقى التأكيد على أهمّية مشروع الحوار الوطني، ومخرجاته التي تكثّفت في “مشروع وثيقة توافقات وطنية”، بوصفه مساهمة جادّة على طريق تلافي النقص الحاد لدى السوريات والسوريين في ثقافة الحوار، وبحث القضايا الإشكالية بذهنية منفتحة، تحاول البحث عن المشتركات، ونقاط الالتقاء التي يبنى عليها، بعيدًا من عقلية الاستقطاب والتمترس الأيديولوجي والسياسي، والتمسّك بأوهام امتلاك الحقائق المطلقة.
—————————-
ملاحظات على موضوعة العلمانية في وثيقة توافقات وطنية/ فارس إيغو
يقول المفكّر العراقي علي الوردي (1913 ـ 1995) “لو خيّروا العربَ بين دولتين دولة علمانية ودينية، لصوّتوا للدولة الدينية، وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية”. بالرغم من التعميم الموجود في هذه العبارة، فإن الواقع يكشف لنا كثيرًا من التناقضات والمفارقات في الوعي عند الإنسان العربي، ومنها تفضيله الذهاب إلى الدول الغربية، حينما يُجبر على ترك بلاده، ويحافظ في الوقت نفسه على كرهه العلمانية، أو على تحفظاته الكثيرة على قبول العلمانية، كأحد المفاهيم المنظّمة للمجال السياسي ومؤسسات الدولة.
ستركّز مقالتي هذه على القول بأن المفهومين الأوليين في الحداثة السياسية هما مفهوما الديمقراطية والعلمانية، وأن شرط العلمانية الضروري للممارسة السليمة للديمقراطية لا يعني الأخذ بآخر ما توصلت إليه المجتمعات الحديثة في هذا المضمار، وأن توفّر البيئة الوطنية المواطنية سوف يكون بداية جيدة لتحقق كل مستويات العلمانية الأخرى مع الزمن، أي بتحقّق حالة من التمايز متقدّمة بين الدين والدولة، وكذلك حيادية الدولة الكاملة، والتي لا تعني عدم احترام الثقافة الدينية لغالبية السوريين.
مقدمة نظرية
هناك تشوش كبير في النقاش حول العلاقة بين الديني وغير الديني، وفي المصطلحات المستعملة من قبل الفلاسفة وعلماء الاجتماع، لتحديد أُطر هذا النقاش تحت هذا العنوان الكبير. والمصطلحات الأكثر استعمالًا وراهنية وإجرائية، في فهم هذه العلاقة وتطورها عبر التاريخ، هما مصطلحا العلمنة والعلمانية.
رأيي الخاص أنّ النقاشات حول هذا الموضوع يجب أن تدور حول هذين المصطلحين الرئيسين: العلمنة والعلمانية، ولا تتشعب وتتعقد وتتيه في مصطلحات فرعية عديدة بدأت تظهر منذ فترة قريبة. وقد بدأت بمصطلح العلمنة (سيكولاريزاثيون أو لاييسيزاثيون)، لأمرين: الأول أنه المصطلح الرائج في العلوم الاجتماعية لبحث عمليات التمايز بين المجالات الدنيوية عن سلطة الدين. وتوفر هذه الأبحاث نظرة تاريخية بعيدة عن سطوة الأيديولوجيا التي أحاطت ظهور مصطلح العلمانية (سيكولاريزم أو لاييسيتي)؛ والثاني أن العلمنة في التاريخ سبقت العلمانية بقرون، وتميّزت بعمليات التحديث في مجالات عدة، نتج عنها تمايز كثير من المجالات الاجتماعية الدنيوية عن الدين (كالفلسفة، العلوم الدقيقة، الاقتصاد والتجارة، التعليم الجامعي.. إلخ)، وتمت كل هذه العمليات بالتدريج وبهدوء، من دون أي عمليات مقاومة كبيرة من قبل الكنيسة في ذلك العصر (باستثناء الانقلاب الكوبرنيكي الذي زلزل الوعي الديني). والشيء نفسه حصل عندنا في العالم الإسلامي بداية من التنظيمات العثمانية، خط أو فرمان كلخانة عام 1839 في عصر السلطان عبد المجيد الأول، وخط أو فرمان همايون عام 1856 في عصر السلطان عبد العزيز الأول(1)، ومن ثم ظهور الدولة الحديثة عن طريق الاستعمار في عملية زرع خارجية لم تترك لهذه المجتمعات الوقت الكافي لإدارة علاقة صحية بين التقليد الموروث عن قرون طويلة من الحكم الإسلامي والتحديث القسري، وشكلت هذه الفجوة عنصرًا من عناصر الرفض للحداثة، حيث بقيت معظم هذه المجتمعات خاضعة لنوع من الحداثة الرثة، هي في الحقيقة تحديث مقطوع عن الحداثة الفلسفية والدينية والسياسية، وما خلقه من مظاهر الفوضى في الحواضر العربية والإسلامية.
بالنسبة إلى مصطلح العلمانية، فإنني أخصصه حصرًا لعملية التمايز أو الفصل ما بين المجال السياسي والدولتي والمجال الديني، وفي نهاية هذه العملية، تكتمل سلسلة عمليات التعلمن بتعلمن الشأن السياسي والتشريعي ونظام الحكم أي تمايزها أو فصلها عن الشأن الديني، وتنشأ ما نسميه الدولة المحايدة. وفي هذه المرحلة، يحدث الاصطدام الكبير مع السلطة الدينية، وكان على أشده في العوالم الكاثوليكية في الغرب، ما أدى إلى تصلب العلمانية في بلدان عدة كفرنسا وإيطاليا، بينما مرت هذه العملية في العوالم البروتستانتية بصورة أقل صخبًا، وأكثر هدوءًا، وانتهت بنوع من العلاقة هي أقرب إلى التمايز من الفصل الحاد، وبالخصوص في الأنظمة الملكية (المثال الإنكليزي الأكثر تعبيرًا عن هذه الوضعية). وقد تكون التجارب العلمانية النادرة في العالم الإسلامي (تركيا، تونس)، على الرغم من خصوصيتها، قريبة من الشكل الفرنسي للعلمانية الصلبة، وإن كانت لا تتماهى معها.
فيالهامش رقم (9) من الوثيقة، يجري تعريف العلمانية على الشكل التالي: “العلمانية تعني فصل السلطة السياسية ومؤسسات الدولة عن الدين والمؤسسة الدينية. فلا يتدخل ممثلو الدين بشؤون السياسة والحكم، ولا تتدخل السلطة السياسية ومؤسسات الدولة بشؤون الدين، بل تبقى حيادية تجاه الأديان والمعتقدات، مع التزامها بحمايتها جميعًا، وتوفير الشروط اللازمة ليمارس أتباعها طقوسهم وشعائرهم وعباداتهم بحرية وأمان”.
هذا التعريف للعلمانية، على دقته المفهومية العالية، يشير إلى السقف الأعلى للمفهوم، وهو الفصل الكامل بين الدين والدولة، أو ما يجري تسميته غالبًا في الكتابات التي تتناول مفهوم العلمانية بـ «العلمانية الصلبة» إشارة إلى العلمانية الفرنسية. ثم في الفقرة (ب)، من بند علمانية الدولة في سورية الجديدة في وثيقة التفاهمات، نقرأ: “ستكون علمانية الدولة السورية القادمة علمانية ليّنة”. فما هي هذه العلمانية اللينة؟ وما مدى انتسابها إلى العلمانية الفصلية، حسب التعريف المعياري الذي حددته التوافقات النهائية بعد سلسلة طويلة من الحوارات دامت عامًا كاملًا؟!
أعتقد أن النقاشات الجارية منذ سنوات حول مفهوم العلمانية تحيل الأمر إلى الغموض التام، ما يشرّع موقف القائلين بعدم جدوى المفهوم لممارسة الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، ومن بين هؤلاء المفكر المغربي محمد عابد الجابري، والعديد من المفكرين الإسلاميين والإسلامويين. ويذكرني هذا التشوش في تعريف المفهوم بالنقاشات التي حصلت في سورية بعد ربيع دمشق عام 2000، في سياق تشكل لجان إحياء المجتمع المدني، حيث كان يتم تعريف المجتمع المدني في أغلب الكتابات التي تناولت المفهوم على أنه مجتمع المنظمات المدنية غير الحكومية، أي المرحلة النهائية التي وصل إليها المفهوم في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، متجاوزين المراحل الطويلة التي قطعها المفهوم خلال ثلاثة قرون ونيف في الغرب، بدءًا من فلاسفة العقد الاجتماعي الذين اعتبروا بروز الدولة بعد معاهدة وستفاليا هي المجتمع المدني الأول في التاريخ الحديث، في حين أن علماء الاجتماع قالوا إن المرحلة الأولى هي تشكل المجتمع القائم على الروابط الصنعية المكتسبة وتجاوز الجماعة التي سادت في العصور الإقطاعية، والتي تهيمن فيها العلاقات الوشائجية (الدينية والمذهبية، الإثنية، والعصبية، وغيرها) (2).
الشيء نفسه، بالنسبة لمفهوم العلمانية، يأتي التعريف الذي تبنته التوافقات بمثابة المرحلة الأخيرة لتطور المفهوم في التاريخ الأوروبي الحديث والعائد إلى نهايات القرن التاسع عشر. ولتصحيح الفهم، يجب الرجوع حوالى أربعة قرون إلى الوراء لمعرفة التجسيد الأولي لمفهوم العلمانية، والذي سيفيدنا لتلمّس الخطى كسوريين في التقدم خطوة أو خطوتين نحو فهم احتياجاتنا لهذا المفهوم في الحياة السياسية السورية.
نظريًّا، العلمانية كمفهوم تطورت بداية في التاريخ الأوروبي ليس في العلاقة مع الديمقراطية وليس بالفصل، بل كحاجة أمام الصراعات المذهبية في أوروبا في القرن السادس عشر، بين الكاثوليك والبروتستانت، لإيجاد رابطة غير دينية بين ساكني الدول الأوروبية، في سياق تشكل الدولة ـ الأمة، بعد معاهدة وستفاليا عام 1648. ثم تطور المفهوم ليصبح مهمًّا لاستقرار وتثبيت النظام الديمقراطي، من خلال ظهور هذا النظام في مناطق أخرى لم تتطور ضمن نفس التواريخ الأوروبية. باختصار: العلمانية كضرورة للديمقراطية لم تظهر في أوروبا أو في الغرب، بل في مناطق العالم الأخرى. لأنّ التطور في أوروبا (المركز) حدث من العلمانية إلى الديمقراطية، بينما في الأطراف المطلب الديمقراطي يستدعي ويتطلب المطلب العلماني، وتصبح العلمانية كمفهوم صراعي بين التيارات الدينية والتيارات الحداثية ـ وبالخصوص في العالم العربي والإسلامي، ما يؤدي إلى انقسام المعسكر الديمقراطي، ويصبح الصراع أو التناقض الأساسي ليس مع النظم الدكتاتورية والنخب المستفيدة منها، بل داخل المعسكر الديمقراطي نفسه.
هناك بعض التجارب الحداثية في المنطقة بدأت بالعلمانية، ومنها التجربتان التركية والتونسية. وتتهم هاتان التجربتان العلمانيتان في منطقتنا بأنهما من التجارب التي قلّدت التجربة العلمانية الفرنسية التي توصف بالصلبة. هذا الكلام غير صحيح، فكل من التجربتين التركية والتونسية له خصوصيته في هذا المجال، لا بل تميّزه عن التجربة العلمانية الفرنسية، وإن كان في التجربتين نوع من الحذر من مظاهر التدين في المجال العام، وليس من التديّن عمومًا كما هو الحال في العلمانية الفرنسية، فإنهما تجربتان لهما كثير من التميّز. إنّ التجربة التركية مالت إلى ما يسمى (دين الدولة)، والدليل وجود وزارة للديانة تشرف على الشؤون الدينية في تركيا. والعلمانية التركية جاءت منذ البداية (مثلها مثل العلمانية التونسية) كتأويل للنص الديني، وليست قطيعة مع الدين الإسلامي، كما يزعم ويردد الإسلاميون بشكل يعبّر عن الجهل بالتجربة التركية، وأحيانًا كنوع من الدعاية الأيديولوجية المضادة التي تهدف إلى تشويه التجارب العلمانية في العالم الإسلامي وتسفيه أصحابها ومؤيديها. صحيح أن الدستور التركي يشير بوضوح إلى أن الدولة التركية دولة علمانية، لكن هذه الإشارة ليست للتضييق على المسلمين الأتراك، كما يفهم البعض جهلًا، بل للإشارة إلى الحيادية النسبية للدولة تجاه العقائد، وثانيًا لتشريع الحرية الدينية للمواطنين الأتراك، كي لا يتعرضوا لأي مكروه أو ضغط من أي طرف كان، حين يعلنون اعتقاداتهم الدينية أو اللادينية بكل حرية، ولإشاعة التسامح والمساواة في المجتمع التركي.
أما عن التجربة التونسية، فهي بالفعل فريدة من نوعها، فلا إشارة في أي مكان في الدستور التونسي إلى مفهوم العلمانية، بل إن الدستور التونسي الجديد الذي صدر عام 2014 ينصّ على أن «الإسلام دين تونس والعربية لغتها»، وهي الصيغة نفسها التي جاء فيها دستور عام 1959. ولكن إلى جانب هذه الصيغة (غير المرضية للعلمانيين) هناك تحديد للدولة في تونس على أنها مدنية، بالإضافة إلى وجود مادة تنص على حرية المعتقد، وهي إضافة جديدة ثانية على دستور عام 1959 في هذا المضمار.
على الرغم من أن التجربتين التركية والتونسية عادتا والتحقتا بركب الدول العربية والإسلامية الأخرى مع صعود الإسلام السياسي في العالم السني والإسلام الثيوقراطي في العوالم الشيعية، فإن التجربتين كانتا الأكثر مقاومة من باقي البلدان للمكاسب التنويرية، بالمقارنة مع الدول التي لم تمر بمرحلة من العلمانية كما مرت بها تركيا وتونس، كذلك كان الإسلام السياسي في البلدين هو الأسبق والأجرأ على الإصلاح والتكيف بسرعة مع تصاعد المطلب الديمقراطي والحقوقي في المنطقة، بداية من التسعينيات من القرن المنصرم.
ونسأل أنفسنا السؤال الأصعب الذي خلق كثيرًا من السجالات في الإجابة عليه: هل العلمانية ضرورة إسلامية – مسيحية؟ أم هي ضرورة إسلامية إسلامية؟ كما قال جورج طرابيشي في كتابه (هرطقات)، لأنه لا يوجد دين من دون سلطة دينية. وكان الجابري قد رفض علمانية الدولة في العالم العربي والإسلامي، لأنه لا يوجد في الإسلام كنيسة أو سلطة دينية.
يعتبر بعض الإسلاميين والإسلامويين أن العلمانية هي بالتعريف فصل رجال الدين عن السلطة، وليس الدين عن الدولة، وبالنتيجة هي إشكالية مسيحية – مسيحية، ما دام الإسلام (على الأقل السني) ليس فيه سلطة دينية ولا كنيسة ولا طبقة رجال الدين (أكليروس) لكي تفصل عن الدولة، وهو التفسير الذي أشاعه محمد عابد الجابري، في كتابه الدين والدولة وتطبيق الشريعة، حيث يقول: وفي رأيي، أن من الواجب استبعاد شعار العلمانيّة من قاموس الفكر القومي العربي، وتعويضه بشعاري الديمقراطيّة والعقلانيّة، فهما اللذان يعبّران تعبيرًا مطابقًا عن حاجات المجتمع العربي(3).
ولكن، حين نسألهم عن التفاصيل، مثل شروط منصب الرئاسة أو رئيس الوزراء، ومرجعيات التشريع، فهم يصرّون على دين الدولة والحاكم، وكذلك على المرجعية الإسلامية في التشريع، ما معناه أن العلمانية ليست الفصل الشكلاني بين رجال الدين والسلطة، بل هناك عناصر أخرى تجعل مفهوم العلمانية مفهومًا مركبًا، له من خلال تطبيقاته عدة مستويات تسير في تحققها مع تطوّر الوعي السياسي لدى المواطنين، من خلال الممارسة الديمقراطية اليومية في المجال السياسي، وكذلك في مجال المجتمع المدني الأكثر التصاقًا بالشؤون العامة اليومية للمواطنين.
لقد أثبت طرابيشي أنه لا يوجد دين دون سلطة دينية تحفّز قراءة رسمية للنص، وتفرضها بالتعاون مع السلطة السياسية، وبالتالي، فكك إحدى أكثر الأطروحات شيوعًا في الثقافة العربية والإسلامية ضدّ مفهوم العلمانية والحاجة إليه كأحد الشروط الضرورية لترسخ الديمقراطية في البيئة الوطنية والمواطنية.
بعد هذه المقدمة النظرية، سوف أحاول أن أقرأ ما بين سطور ما جاء في فقرة العلمانية في وثيقة توافقات وطنية.
الوطنية والمواطنية كأساس للبناء السليم للديمقراطية في سورية
تقول الوثيقة: “العلمانية خيار ضروري لإنقاذ سورية ممّا هي فيه، ولبقائها دولة موحدة، ولتوفير شروط استقرارها وقدرتها على النهوض والتقدم، لسببن رئيسين: الأول هو حالة التعدد والتنوع الديني والإثني التي تميز سورية”.
برأيي الخاص، ليست العلمانية لعلاج مسألة التعدد والتنوع الديني والإثني ولتوحيد سورية أو أي بلد آخر، ولا أتكلم عن الفصل، لأن تمايز المجالات أصبح تحصيل حاصل في العصر الحديث، بل هي في رأيي لتثبيت صندوق الاقتراع (لتثبيت وتصليب الديمقراطية) ضمن ثقافة وطنية – مواطنية.
إنّ ضرورة قدر معيّن من العلمانية تأتي من أن الديمقراطية من دون العلمانية تنتج ديمقراطية المحاصصة الطائفية، حيث تتشكل الأديان والمذاهب ضمن طوائف سياسية، والإثنيات تتصلب سياسيًّا لتصبح قوميات. ليست العلمانية للخلاص من التنوع الطائفي والمذهبي والإثني، بل لتجنب تسييسها.
ونتجنب التسييس بالعلمانية بطريقتين: الأولى ثقافة المواطنة التي تنفرز كمفهوم من الديمقراطية والعلمانية، والتي تخلق أفرادًا أحرارًا يتصرفون كأفراد، بالرغم من انتماءاتهم الدينية والمذهبية والإثنية. والثانية ثقافة الانتماء غير الديني للإقليم المخصص للجماعة السورية (الوطن، هو الإقليم الذي يرتبط ساكنوه بثقافة سياسية وطنية، نسميها الانتماء الوطني)، تنتج عن المدرسة الجمهورية. هنا، نقتلع الأطفال من ثقافاتهم الضيقة التي تشربوها ضمن العائلة، إلى وسع الثقافة الوطنية بتنوعاتها المختلفة، والتنوع يصبح هنا إضافة وليس عائقًا.
ونعرف أن معركة المدرسة الجمهورية هي أساسية لتثبيت المفهوم الأول للعلمانية، أي الرابطة اللادينية للأفراد في الوطن، ما يفسر العلاقة الضرورية بين إجبارية التعليم ومجانيته.
ومن هنا، علينا أن نتوجس من كلّ ظهور وتكاثر للمدارس الخاصة الطائفية أو غير الطائفية، لماذا؟ إنّ ظهور المدارس الأولى (الخاصة الطائفية) يعني أن العلمانية ليست بخير، حيث يبدأ المجتمع بالانقسامات الطائفية، وتفضيل إرسال الأولاد إلى ما نسميه بسورية بالمدارس الموحدة. ولا يُعتبر ظهور المدارس الثانية (الخاصة غير الطائفية) مؤشرًا سليمًا في المجتمع، لأنها تعني وجود طبقة غنية جدّا تستأثر بالثروات، ولا تثق بجودة المدرسة الجمهورية، وتريد الانفصال بأولادها عن باقي الطبقات (4).
حيادية الدولة والعلمانية اللينة
تقول الوثيقة: “ستكون علمانية الدولة السورية القادمة علمانية ليّنة، تناسب السوريين، وتتلاءم مع بيئتهم وثقافتهم، يتم اجتراحها انطلاقًا من فهم معوقات العلمانية في مجتمع يؤدي فيه الدين دورًا مهمًّا، وتعاني فيه العلمانية من سوء الفهم والسمعة والمواقف السلبية المسبقة. والعلمانية الليّنة المطلوبة تعني أن يقتصر تطبيق العلمانية على مستوى شؤون الحكم ومؤسسات الدولة فقط، وليس على مستوى المجال العام، فيكون للناس حرية ممارسة شعائرهم والتعبير عن معتقداتهم في الفضاء العام، بالطريقة التي تناسبهم، وبما لا يخالف القانون، بل من واجب الدولة حمايتهم واحترامهم”.
لكن، ما التحديد المعرفي لهذه العلمانية اللينة المزعومة؟ وما الذي يميّزها من حيث الليونة عن العلمانية الصلبة المشيطنة من قبل كثيرين؟
ليس لدينا في الحقيقة أدبيات كثيرة لتحديد ماذا تعني العلمانية اللينة؛ يقول عزمي بشارة، صاحب سلسلة المجلدات عن العلمانية والعلمنة (3)، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، بأنّ هذه التسمية غير دقيقة، ويستبدل هذا التوصيف بالتحديد المعرفي بتحييد الدولة عن الشأن الديني بطريقين: الأول رفض ما يسمى بدين الدولة، أي استخدام الدين من قبل الدولة، وذلك عن طريق الإشراف على خطب الجمعة والتعيينات المهمة في المؤسسة الدينية وغيرها، والثاني هو عدم استخدام الدولة من قبل السلطة الدينية لتحديد عقائد الناس أو استخدام سلطة الدولة البوليسية والقضائية لقمع المخالفين، ومنع بعض الكتب والمقالات تحت عنوان كبير يسمونه بـ «ازدراء الأديان».
لكن تحييد الدولة ليس ممكنًا دون الفصل الكامل بينها وبين الدين، ولا أعتقد بأن صيغة الفصل في العلمانية السورية «تناسب السوريين، وتتلاءم مع بيئتهم وثقافتهم»، وكذلك لا أعتقد بأنها قابلة للتحقق في الحاضر القريب والمتوسط. يبقى الفصل بين السلطة الدينية والدولة أحد مطالب التيارات الحداثية في سورية، لا ينبغي التنازل عنه بالطبع، ولكن من جهة أخرى، يجب محاولة بناء توافق عريض على الحد الأدنى من العلمانية، لضمان سير العملية الديمقراطية بطريقةٍ تجنبها الانحراف نحو التجارب الفاشلة فيما يسمى ديمقراطية المحاصصات. الطائفية (لبنان، العراق)، هذا الحد الأدنى هو الذي نعبّر عنه بتهيئة كل شروط تحقق (الثقافة الوطنية المواطنية)، في برامج التعليم والإعلام الرسمي والمواد الدستورية التي تشدّد على المواطنة الكاملة والمتساوية بين جميع حاملي الهوية والجنسية، وهو ما يتطلب من التيارات الإسلامية والتقليدانية في سورية التخلي عن المواد الدستورية غير المعقولة، مثل دين الدولة أو دين الرئيس.
إن المطلب الديمقراطي في سورية منذ نهاية السبعينيات كان يقتصر على النخب السياسية والفكرية، وأصبح مطلبا اجتماعيًا مع ربيع دمشق عام 2000، وتحول إلى مطالبات شعبية عارمة تحت شعار الحرية والكرامة مع انطلاقة الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، هذا المطلب الديمقراطي يقتضي بالضرورة لتحققه الحد الأدنى من العلمانية، اي ثقافة وطنية ومواطنية وما تتطلبه من تغييرات على مستوى الدستور وبرامج التعليم المدرسية..
وكثير من المفكرين في الشأن السياسي يعتقدون بأنّ حيادية الدولة حتى مع الفصل الكامل بين الدولة والدين تبقى نسبية، كون المفاهيم الاجتماعية أو الإنسانية ليست من طبيعة المفاهيم العلمية في العلوم الدقيقة (يعني 1+1=2)، بل هي تبقى نسبية تحاول ما أمكنها الاقتراب من صدقية المفهوم أو عناصره. يعني لا يوجد ديمقراطية كاملة مُكملة، وكذلك لا يوجد علمانية كاملة مُكملة، وهو نقاش يُسترجع في كل مرة بشكل سجالات كنوع من فقه المناكفة مثلًا: إنكلترا ليست علمانية، لأن الملك رئيس الطائفة الأنجليكانية. كثير من هذه الانتقادات السجالية تستند إلى فكرة خاطئة عن المفاهيم في العلوم الإنسانية وتطبيقها في الواقع الاجتماعي.
في سورية، العلمانية سوف تتأقلم مع ثقافة الشعب الدينية الغالبة، هذا أمر طبيعي، حتى إنه لا يحتاج إلى مادة في الدستور أو قوانين ومراسيم، ويبقى عرفًا من الأعراف. والعلمانية، التي نريدها لسورية ليس لها أي رغبة في محو الثقافة الدينية للسوريين، فازدهارهم الروحي أمرٌ مهم لصحتهم النفسية، لا ننسى، بالإضافة إلى ذلك، أن عدد السوريين غير الراغبين في الانتماء إلى دين معين يزداد باطّراد.
لذلك، لا داعي لهذه التسميات (علمانية لينة، علمانية مرنة، علمانية مرحة، علمانية غير صلبة، علمانية جزئية، إلخ)، هي علمانية حسب حاجات مجتمعنا ضمن تطوره الحاضر، وتتماشى مع المطالب الديمقراطية في تحقيق الحرية والكرامة للإنسان السوري، ويمكن لهذه العلمانية أن تتطور مع الزمن، بالعلاقة مع تطور المجتمع السوري من خلال الممارسة الديمقراطية العملية، وفي سياق تطور قواه الإنتاجية والعلمية والتقنية والروحية.
بعض الأخطاء في الصياغة النظرية لفقرة العلمانية في الوثيقة
ـ تقول الوثيقة: «تقتضي العلمانية المنشودة تلازم مفهوم العلمانية وتكامله مع مفهومي المواطنة والديمقراطية».
الجملة فيها خلط في مستوى ترتيب المفاهيم، ففي المستوى الأول للمفاهيم في الحداثة السياسية، تأتي مفاهيم الديمقراطية والعلمانية، والمواطنة كمفهوم يأتي في مستوى ثان هو إفراز للمفهومين الأساسيين السابقين.
ـ تقول الوثيقة أيضًا: «فدولة المواطنة لا بد أن تكون علمانية، والعكس صحيح، لأن المواطنة تفترض أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع». وهذه مغالطة، نتجت عن العبارة السابقة. فالديمقراطية والعلمانية تفرزان بالممارسة مفهوم المواطنة وتكرسانه كحقيقة يومية في المجتمع السياسي. ليست المواطنة هي التي تؤدي إلى أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع، بل الديمقراطية والعلمانية معًا تفرزان مفهوم المواطنة.
وإذا كنا أكثر دقة، نقول إن الأولوية يجب أن تكون لمفهوم الديمقراطية، والمفاهيم الأخرى هي شروط تحقق هذه الديمقراطية في الممارسة، ومنها مستوى من مستويات العلمانية (أي الرابطة اللادينية بين أفراد الجماعة السياسية)، والثقافة المواطنية المدنية.
ـ وتقول الوثيقة: «والنظام الديمقراطي لا بد أن يكون علمانيًا». والأصح القول: لا بدّ أن يكون على قدر من العلمانية يحقق المواطنة المتساوية الكاملة.
ـ وتقول الوثيقة: «والعلمانية لا تقوم دون بيئة ديمقراطية». قلنا تاريخيًّا، العلمانية قامت من دون بيئة ديمقراطية في أوروبا.
ـ وتقول الوثيقة: «فالاستبداد لا يمكن أن يكون حياديًا بحال من الأحوال».
صفة الإطلاق غير موجودة في المفاهيم الاجتماعية. هناك استبداد مستنير في التاريخ لم يكن طائفيًّا، وقد بنى الدولة، وفي عالمنا المعاصر هناك المثال الصيني واضح أمامنا. أما الروسي، فقد بدأ ينحرف نحو المافيوزية مع رئاسة بوتين، ظاهرة فاغنر الميليشيوية أكبر دليل. في العالم العربي، هناك المثال التونسي في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة كان استبدادًا مستنيرًا، وقامت الدولة بأغلب واجباتها العمومية، وبالخصوص في التعليم والمساواة بين الرجل والمرأة. وفي منطقة الشرق الأوسط، هناك الاستبداد المستنير في عهد الزعيم مصطفى كمال أتاتورك، فالدولة الأمة في عهده أتمت واجباتها التنويرية والدمجية بصورة معقولة.
ـ وتقول الوثيقة: «يجب ألا يتضمن الدستور والقانون أي نصوص تشير إلى التمايز بين الجماعات السورية، ويجب أن تكون التشريعات وضعية. والدولة السورية الجديدة يجب أن تكون منزوعة الصفات، لأنها فضاء مشترك لا يجوز احتكاره من قبل أي جماعة، مهما كانت كبيرة، لأن في ذلك إقصاء لجماعات أخرى».
في البداية، لا نضمن ذلك، ستحدده درجة الوفاق وقوة التيارات الحداثية. فـ (يجب) في السياسة لا مكان لها، تبقى السياسة في الديمقراطيات نوعًا من التفاهمات القابلة للتعديل والتطوير مع الزمن.
في الخلاصة، هذه بعض الأفكار التي يمكنها أن توسع آفاق التفكير حول مسألة العلمانية في الوثيقة، والتي يمكن تلخيصها بأنّ الأساس العلماني الذي يجب أن ننطلق منه في حالتنا الراهنة، حيث المطلب الديمقراطي هو الأكثر حضورًا بين السوريين، هو قدر من العلمانية يؤمّن دمج السوريين عن طريق الثقافة الوطنية المواطنية، بواسطة الأجهزة التي تسيطر عليها الدولة كالمدرسة الجمهورية المجانية والإعلام الرسمي، والنص الدستوري بالمساواة الكاملة بين السوريين، ما يفترض إلغاء بعض المواد الدستورية التي تخص دين الدولة ودين الرئيس، وأما الأمور الأخرى، كمرجعيات التشريع ودرجة حيادية الدولة والنص الصريح على الفصل، فهذه ستخضع للتوافقات. لكن، على الأقل علينا أن ننطلق بالحد الأدنى الذي يقوم على مرتكزين أساسيين هما الهوية الوطنية والمساواة المواطنية الكاملة.
يبقى أن هذه الوثيقة في ما يخص فقرة العلمانية لم تعرض بصورة تامة موقفَ طرف أساسي في الوطن هو الإسلام السياسي، ولكن لا يستدعي ذلك اعتبارها ناطقة باسم «الأقلية الوطنية… تلك الفئة المجتمعية التي ترى حياتها في الماء الذي تسبح فيه»، فهذا المنطق الارتكاسي لا يُسهم في تجاوز المحنة السورية، والاتجاه نحو بناء مجتمع سوري يكرس الحرية والمساواة المواطنية الكاملة.
……………………………
الهوامش
1ـ عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف: الدين والدنيا في منظار التاريخ، الطبعة الأولى، (مركز دراسات الوحدة العربية، 1992).
2ـ عزمي بشارة، المجتمع المدني : دراسة نقدية، الطبعة السادسة (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).
الطبعة الأولى للكتاب عام 1996، وصدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية، وظهرت منه ثلاث طبعات عن المركز في بيروت، ثم صدرت طبعتان منه في فلسطين، ثم صدرت الطبعة السادسة الجديدة في 2012 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
3ـ محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، الطبعة الأولى (مركز دراسات الوحدة العربية، 1996، ص : 108 ـ 114).
4ـ لست هنا لكي أمنع أو أجيز المدارس الخاصة، بل لأكشف الأسباب والآثار الاجتماعية لظهور وتنامي هذه الظاهرة، فالمهمة الأولى للمثقف هي البحث فيما وراء الظواهر، ليكشف بعض خلفياتها غير المرئية أو غير المقروءة للجمهور، وليس لكي يمنع أو يجيز، فهذه مهمة السياسيين المنتخبين من الشعب.
5ـ ثلاثية عزمي بشارة في «الدين و العلمانية في سياق تاريخي».
ـ الجزء الأول: الدين والعلمانية في سياق تاريخي: الدين والتديّن (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة – بيروت، صدرت الطبعة الأولى 2013)، عدد الصفحات 496 من القطع الكبير.
ـ الجزء الثاني ـ المجلد الأول: الدين والعلمانية في سياق تاريخي: العلمانية والعلمنة الصيرورة الفكرية (من إصدارات المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى 2014)، عدد الصفحات 912 من القطع الكبير.
ـ الجزء الثاني ـ المجلد الثاني: الدين والعلمانية في سياق تاريخي: الصيرورة التاريخية وعملية العلمنة (المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، الدوحة – بيروت، الطبعة الأولى 2014)، عدد الصفحات 480 صفحة من القطع الكبير.
الكتاب هو دراسة تاريخية عن تطور العلمنة والعلمانية في الغرب، وفي نفس الوقت محاولة لتفكيك السرديات الكبرى المحيطة بمفهومي العلمنة والعلمانية (انظر في هذا الصدد كتاب «نظرية العلمانية عند عزمي بشارة: تفكيك السرديات الكبرى للعلمنة والعلمانية» للباحث مصطفى آيت خراوش).
—————————–
ملاحظات جزئيّة على مشروع وثيقة توافقات وطنية/ عيسى إبراهيم
النقاط التي يناقشها مشروع توافقات وطنية هي نقاط جوهرية جديرة أن تكون كلمة سواء، بين السوريين والسوريات المتنوعين، وبكل مستوى من التنوع.
هنالك بعض التفاصيل التي أرى أن من شأنها تعزيز انتصار هذا المشترك المُتمثل بالمشروع داخل النفس السورية، ليكون مدخلًا لبلورة مجتمع سوري يحمل مفاهيم قانونية مشتركة يلتزم بها ويحتكم إليها، وذلك عبر مزيد من التحديد والتعيين لتحقيق مزيد من الوضوح.
في التفاصيل:
* في الفقرة المتعلقة بالعلمانية المُشار إليها بالفقرة (ش)، وكذلك في الفقرات اللاحقة، أقترح مباشرة بعد كلمة علمانية وضع قوسين، وتوضيح المعنى المراد والمقصود بالعلمانية المراد لها التبني في سورية، أينما وردت، كي لا يتمّ تأويلها بما ليس منها وفيها. وأقترح الصيغة التالية: (العلمانية المقصودة: الاعتراف بحق التدين من عدمه، وعدم استخدام الدين في السياسة، أو السياسة في الدين، حيث التدين حقّ روحي، والسياسة مجال تناول علمي للعلاقة مع الشأن العام المشترك، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، وبما يضمن دور كل من الدين والسياسة، كلّ في مجاله دون طغيان، حيث الدّين يُعزز الأخلاق والقيم الروحية ويسهم في تعزيز الوجدان المجتمعي، و السياسة تضمن عمل المؤسسات وتمكين المواطنين من القيام بواجباتهم وحقوقهم بمعزل عن هوياتهم الفرعية المتنوعة، ووفق مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث لا ينعكس الدين أو القومية أو المناطقية على هيكلة المؤسسات العامة والتعيين في الوظائف، سواء في الجيش والأمن أو الاقتصاد أو الوزارات …الخ، وكذلك بما يضمن المواطنة المتساوية للسوريين والسوريات).
* في موضوع العدالة الانتقالية، أقترح إضافة عبارة: (إن المدخل للسلم الأهلي المستدام، وللاستفادة من التجربة الإنسانية المريرة التي مرّ بها السوريون والسوريات خلال ما سبق، ولبناء تجربة حضارية متمدنة، هو محاكمة مجرمي الحرب)، والمقصود هنا هو التعريف القانوني لمفردة جريمة حرب، وهو: “استهداف المدنيين دون تمييز، ومن أي طرف كان، وتحت أي راية مارسوا جرميتهم تلك، ومهما بلغ عددهم، ومن أي فئة كانوا”. فبزعمي هذا شرط مهمّ لبناء ثقة بين السوريين والسوريات، ولا يمكن تجاوزه، بل هو شرط لا بدّ منه لبناء وحدة وطنية، “المعنى الاصطلاحي لكلمة وطنية هنا وليس المعنى التفاضلي”.
* فيما يتعلق بالقواعد الدستورية المحصنة، وإن كنت أُدرك أن استخدامها هنا جاء كبديل في الصيغة عن صيغة المبادئ فوق الدستورية، المستفزة لدى بعضهم، وبصيغة مخففة لذلك… بيد أنه من المهم الإشارة إلى عدم وجود قواعد فوق دستورية بالأصل، بل هي قواعد دستورية معيارية تُعطي للدستور شرعية التسمية، ودونها لا يمكن تسميته دستورًا، ولا يمكن تقبل كونه دستوريًا، وإن سُمّي دستورًا بالغصب والاكراه. وأقترح إتباع كلمة القواعد الدستورية بالمحصِّنة، بالإشارة إلى كونها قواعد دستورية معيارية، والتركيز عليها جاء بسبب ضرورتها للتفاعل المجتمعي المتناغم والمُنتج وعدم الطغيان فيما تقدّم.
* وبالتالي، تبيان كونها معيارية مهمّ، حتى لا يبدو تعبير “حصانة استثنائية” وكأنه مُصادرة مسبقة لإرادة السوريين والسوريات. مثلًا في الفقرة (ث)، أقترح إتباع فقرة بكلمة معيارية، بحيث تصبح الفقرة كالتالي: أهمّ ما يُناط بالقواعد الدستورية المحصَّنة المعيارية …. الخ، وإذا كان ممكنًا أقترح أيضًا جعلها بكسر الصاد: القواعد الدستورية المُحَصِّنة المعيارية … والغاية المقصودة هنا هو أن هذه القواعد دستورية، وليست قواعد فوق دستورية أو طارئة على الدستور لظرف استثنائي، كما قد يُفهم من بعض ردات الفعل لغير المختصين على هذا التوصيف، حيث اعتبرت من بعضهم مصادرة لإرادة الناس !
فهي -وفق هذا التوصيف الذي سُقته- دستورية ومن صلب الدستور، مُطلق دستور، ووجودها شرط أساس ومعيار لبقاء الدستور دستورًا، من حيث الماهية والفقه الدستوري الناظم للدساتير عادة، ووجودها تحصين للدستور، وبما يجعل وجود هذه القواعد واحترامها مُحصِّنًا ومعيارًا لبقاء الدستور دستورًا، فبدونها لا يمكن اعتبار الدستور دستورًا، وإن سُمِّي دستورًا كما الدستور الحالي الذي هو أشبه بـ “لائحة تعليمات تنفيذية”، وليس دستورًا. وعندما يُسلّط الضوء على هذه القواعد المشار إليها أعلاه دائمًا وتحترم، فالمقصود أن يكون الدستور متوافقًا مع الفقه الدستوري العام وضامنًا لحياة سياسية مجتمعية طبيعية، بعد سلسلة من الظروف الخاصة، أو بعد التحولات الكبرى التي مرّت بها سورية والسوريون.
* في الفقرة (أ) بموضوع الفصل بين السلطات في سورية، أقترح استبدال كلمة عبارة “النظام السياسي في سورية القادمة على مبدأ فصل السلطات”، بعبارة “يَحترم النظام السياسي في سورية القادمة مبدأ فصل السلطات كمبدأ معياري دستوري…. الخ”، حتى لا يُفهم أن مبدأ فصل السلطات خاص بسورية القادمة أو أنه هو ليس جوهر دستورية الدستور، أو أن دمج السلطات الموجود الآن في “الدستور” هو مبدأ دستوري بالأصل!
* في الفقرة المتعلقة بشكل الدولة السورية الجديدة، أقترح الاستعاضة عن كلمة بلديات، بكلمة “المقاطعات ومجالسها المحلية…. الخ”، وأن يتم إتباع كلمة “المقاطعات” بعبارة “ذات الطابع الإداري الجغرافي الأكثر تكاملًا …. ” مع التأكيد على طبيعة التنوع السوري، بكل مستوياته، المتداخل في كل سورية وضمنًا في المقاطعات الجديدة.
يقتضي اعتماد نظام المقاطعات دمج محافظات عدة (قد يصل عدد المقاطعات من ست إلى سبع مقاطعات في كل سورية)، تُشكّل مع بعضها مساحة مكانية، فيها حد أدنى من التناغم المجتمعي والقيمي والاقتصادي ودورة الحياة.. الخ، وحيث يكون لكل مقاطعة مجلس تمثيلي منتخب، وهيكلية إدارية مناسبة، وبما يضمن الاستفادة من الثروات المحلية في خدمة المكان وتنمية الأطراف، مع حصة للمركز تُسهم في الصرف على المهام المركزية التي تبقى من حصة المركز، من قبيل الدفاع والخارجية والبنك المركزي.. الخ، وعلى أن يكون هنالك على مستوى المركز غرفتان: غرفة لمجلس النواب وغرفة لمجلس الشيوخ الذي يتشكل من مرجعيات وخبرات في الاقتصاد والعلوم، بما فيها المجتمع والسياسة، حيث تُحدد لهذا الأخير آلية لتعيين أعضائه لاحقًا، باعتباره مجلس حكيم وصمّام أمان مجتمعي لضمان صيرورة سياسية منتجة على المستوى السوري العام بمسائل التنمية.
* معالجة المسألة الطائفية والقومية والمناطقية تبدأ -بزعمي- بتبني اللغة القانونية في تناول الحديث العام، دون الدخول في مجاملات أو اتهامات فئوية، وكذلك بالاحتكام إلى القانون في ما يخص أي تهديد للوحدة المجتمعية، من خلال التركيز على المواد الدستورية والقانونية التي تُجرّم أفعالًا بعينها، تُشكِّل تهديدًا لوحدة المجتمع السوري، وكذلك محاكمة مجرمي الحرب المُشار إليها آنفًا، وكذلك الإقرار بالحقوق الثقافية للجماعات البشرية المُشكّلة للمجتمع السوري والدولة السورية، من قبيل اللغة واعتمادها في التعليم والتعلّم ووسائل الإعلام، والعادات والتقاليد والأعياد، وعدم إطلاق صفة فئوية على تسمية الدولة السوريّة الجديدة.. الخ، وعدم اعتبار ذلك نقطة ضعف في الوحدة المجتمعية، بل عامل تعزيز للتناغم المجتمعي، في ظلّ قانون يضبط إيقاع المجتمع بمعزل عن الهويات الفرعية، وكذلك التمييز بين الحقوق الثقافية للجماعات المُشكِّلة لسورية وبين حقوق الأفراد التي هي جوهر الحقوق السياسية، من قبيل حق التعبير والتصويت والترشح والترشيح.. إلخ.
إن ضمانة احترام هذه التوافقات الدستورية، من السوريين والسوريات، هي بمثابة بناء الهوية السورية الجديدة على مفهوم المصلحة المشتركة، وهي تبدأ من المصلحة الاقتصادية المشتركة إلى المصلحة السياسية والأمنية، وكل أشكال المصلحة، وعدم إدخال الأدلجة في تصور سورية المشتركة، خاصة أن الغالب لدى السوريين والسوريات هو تباين نظرتهم الأيديولوجية إلى هذه الـ “سوريا”، وإن تحدثوا عنها وعن رغبتهم فيها، فهم مختلفون في تصورهم عنها، بل كثير منهم يعتبرها جزءًا تفصيليًا في فضاء أيديولوجي ممتد خارج الحدود، لذلك التركيز على مفهوم المصلحة والمصالح وقوننته أمرٌ غاية في الأهمية، لضمان استمرارية احترام هذه التوافقات الدستورية المكتوبة وضمان تنفيذها والتقيد بها.
ولمزيدٍ من بلورة هذه التوافقات وإشراك الآخرين فيها، أقترح اختيار عناوين جزئية منها، لتكون عناوين للقاءات على الزووم أو التلفزيون أو مقالات، قابلة للتفاعل. وطرحها عبر منابر عدّة، لتصل إلى تقبّل مجتمعي بحد مشترك مقبول يُبنى عليه.
———————————-
مشروع وثيقة “توافقات وطنية”.. ما لها وما عليها/ ريمون المعلولي
يحرص المشتغلون في إعداد الدراسات أو التقارير والوثائق على اتباع تقاليد العمل العلمي – الموضوعي، ومنها مجموعة المعلومات التي تخصّ المنهجية التي اتّبعوها في جمع البيانات وأساليب معالجتها، لجهة تصنيفها والتعامل معها واعتمادها، مع ذكر الأدوات المستخدمة عند الحصول على البيانات (جمعها): كالمقابلات والاستبانات والملاحظة… الخ.
وكذلك يتم تعريف القرّاء بحجم العيّنة التي قدّمت البيانات، ودرجة تمثيلها للمجتمع المعنيّ، ومدى إمكانية تعميم النتائج/ البيانات على ذاك المجتمع، فضلًا عن الفترة الزمنية التي استغرقها جمع البيانات وتاريخ البدء والانتهاء منها، وهذا أمر ضروري، لأن المعلومات قد تتغيّر مع الزمن -خاصة تلك التي تكون من طبيعة بيانات الرأي- فما كان متوافقًا عليه في وقتٍ ما قد لا يكون كذلك في وقت آخر.
من أجل تحقيق هدف صياغة وثيقة “توافقات وطنية”، اعتمد فريق إدارة الحوار الوطني (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) على دعوة “عيّنة ضمّت عددًا من المثقفين والأكاديميين والسياسيين السوريين، يمثّلون -كما جاء في التمهيد لمشروع الوثيقة- اتجاهات ومكونات سوريّة متنوعة، لمناقشة محاور تولّى وضعها فريق إدارة الحوار، وحقّق ذلك عبر مجموعة من الندوات، ما أنتج مشروع الوثيقة التي دخلت قيد التداول والنقاش العام، بغية تعميقها وبلوغ مزيد من التوافق حولها.
وبحسب فريق الحوار، فإنّ الدافع الرئيس لتنفيذ هذا المشروع يكمن في عجز السوريين عن إنتاج وثيقة سياسية متوافق عليها؛ “فالمبادرات السابقة كانت تصدر من جهة محددة أو مجموعة مختارة تشبه بعضها، فتأتي المبادرة بلون محدد يناسب رؤية من أصدرها، فتصطدم برفض الآخرين بسبب مُصدريها أو بسبب محتواها”. ولذلك لا بدّ من الاشتغال على وثيقة تحظى بموافقة/ توافق أكبر عدد من الطيف السوري.
ما يميّز الوثيقة -بحسب ما جاء في التمهيد لها- أنها “تضمّ المبادئ والأسس التي يفترض أن تساعد البلاد في التعافي، وبناء الدولة الحديثة، فضلًا عن ضمّها لشروحات وتعريفات لبعض المصطلحات والمفاهيم، والمقترحات لما يمكن عمله. وبالتالي، يمكن لهذه الوثيقة أن تكون مادّةً مرشدةً للدراسات وبرامج العمل والمشاربع المتعلقة ببناء سوربة، ومادةً لإثارة النقاش حول موضوعات تهمّ السوريين”.
وفي مقدمة الوثيقة، يُذكِّر فريق الحوار بالأهمية التطبيقية المتوخاة منها: “أنها تمثل إحدى أدوات النضال السياسي الضرورية لبناء الوعي حول مفاهيم تتعلق بسورية القادمة. لذا يمكن عدّها أداة توعية وتنوير وتثقيف للسوريين”، وهي من هذه الزاوية يمكن أن تساعد في تقريب وجهات السوريين الفكرية والسياسية، ما قد يساعدهم في تكوين الحامل المناسب الملائم لهذه الرؤية السياسية – الفكرية.
ومن منطلق الحرص على وثيقة “توافقات وطنية”، وبغية إكسابها مزيدًا من المصداقية؛ أرى ضرورة تسجيل عدد من الملاحظات التي ينتمي جُلّها إلى المنهجية المتّبعة في أثناء التحضير للندوات، وتفريغ محتوى جلسات الحوار، وجمع الآراء وتصنيفها وتبويبها، من خلال عدد من الأسئلة:
1-ما مدى مراعاة العيّنة المختارة -وهم الشخصيات التي دُعيت للمشاركة في الندوات الحوارية- لتمثيل السوريين بتنوعاتهم المختلفة؟ وما محددات اختيارها؟
لم تُجب الوثيقة عن مدى تمثيل عيّنة الشخصيات التي دُعِيت لندوات الحوار، سوى أنها “ضمّت عددًا من المثقفين والأكاديميين والسياسيين السوريين، يمثلون اتجاهات ومكونات سورية متنوعة: سياسية واثنية وجغرافية. وهم يمثّلون أوسع طيف ممكن من السوريين”. (شارك 186 سوريًّا من المتخصصين…. ومن مختلف الانتماءات والاتجاهات).
لم تتضّح للقارئ كيفية اختيار أفراد العيّنة، والمعيار الذي استُند إليه عند الاختيار. وهل تم تمثيل المرأة ضمن هذه العيّنة بما يكفي؟ وما نسبة تمثيلها؟ فالقارئ يحتاج إلى الاطمئنان عن صدق تمثيل المدعوين لجميع أطياف المجتمع السوري، ومن الجنسين.
2- كيف تم انتخاب/ اختيار الأفكار التي وُضعت في الوثيقة؟ هل من معيار تم الركون إليه يتّسم بالثبات الموضوعية، أسهم في فرز الأفكار والآراء التي أدلى بها المتحاورون؟ وإذا كانت لجنة الحوار المكلفة بالصياغة قد اتبعت معيارًا ما، فما هو؟ هل كان معيارًا يعتمد عدد مرات تواتر الفكرة خلال الندوة؟ (مقياس كمي)، أم أن اختيار/ انتخاب الأفكار جرى استنادًا إلى مقياس نوعي، يعتمد مدى توافق الفكرة مع ما ينسجم مع الأهداف التي حُددت للوثيقة مسبقًا (معيار نوعي): على سبيل المثال، “التوجّه الديمقراطي المدنيّ والدولة الحديثة…؟ وكما نعلم، فإن الفرق كبير بين هذه وتلك من المعايير، لجهة الموضوعية والذاتية، الأمر الذي يدعم أو يضعف من مصداقية عنوان الوثيقة، وصدق التمثيل للتنوعات السورية.
ويتصل بالفكرة السابقة السؤال عن عنوان الوثيقة “توافقات وطنية”، ما يعني أن أي مكون سوري سوف يجد ذاته فيها!
وأرى أنه من الأفضل أن يكون هناك تحديد مسبق للخيارات الفكرية – السياسية التي تتّصل بمستقبل سورية، وأن يتمّ -بناء عليها- انتخاب الشخصيات التي تتوافق مع تلك الخيارات. كأن يكون الخيار “الدولة الديمقراطية الحديثة”، بكلّ مضموناتها ومحدداتها، وهذا الطرح واقعيّ، وممكن أن ينتج عنه وثيقة توافقية، ولكن داخل تيار معين، لأن بلوغ وثيقة تمثل توافقات وطنية هكذا… وبشكل عام، كما فهمنا من الوثيقة، غير ممكن عمليًا، فالتنويعات الفكرية والأيديولوجية لا تسمح ببلوغ توافق ناتج عن خلفيات متنوعة. وغالبًا ما سيكون توافقًا مصطنعًا وليس حقيقيًا.
– ما مدى قدرة الوثيقة على تكوين الحامل المناسب لتحمّل مسؤولية المسألة السورية؟
وهنا يُطرَح التساؤل: كيف يمكن لوثيقة تدّعي بأنها حقّقت التوافق الوطني، أي الإجماع الوطني، أن تُسهم في تكوين حامل منسجم وفعّال؟ وقد علّمتنا التجربة أن المشكلة التي تعانيها النخب السورية مركّبة، يغلب عليها الطابع الذاتي، وترتبط بمدى نضج خبرات الشخصية السورية عمومًا، والنخب خصوصًا. فلم تكن الوثائق/ المشاريع وحدَها هي ما ينقص السوريين عند محاولاتهم تكوين الحامل التنظيمي الوازن.
– ما الحدود الزمانية للوثيقة: ما زمن جمع المعلومات؟
ذكرت الوثيقة أن الجلسات الحوارية تمّت على مدى 13 شهرًا، وبرأيي هذا غير كافٍ، ولا بد من ذكر الزمن، أي أن يكتب: عقدت جلسات الحوار في الفترة الممتدة بين شهر…. عام…. حتى شهر….عام…. فللمعلومات صلاحيتها الزمنية، وخصوصًا تلك التي تحمل مضمونات إشكالية-جدلية.
* قد لا يُتاح للجنة الحوار توفير المتطلبات المتصلة بالنقاط التي تم نقاشها أعلاه، ولكن يمكن إعادة صياغة التمهيد والمقدّمة بشفافية أكبر، كي تبدو الوثيقة معبّرة عن حقيقتها، وهذا أدعى لبلوغ مزيد من المصداقية والموثوقية لدى القراء.
* إنّ توفير أوسع مشاركة جماهيرية، لمناقشة الوثيقة والتعامل مع مخرجاتها بجدّية، أمرٌ ضروري لبلوغ توافق أعمق، بين ممثلي تيار فكري-سياسي معيّن تم اختياره، يمكن أن يقدّم رؤيته لسورية المستقبل، ما يسهم في تكوين الحامل المنسجم مع هذا الخيار.
* من الضروريّ التذكير بأنّ الوثيقة تمثّل كيانًا حيًّا يتطوّر من خلال الإغناء والحذف والإضافة، أي عبر النقاش المفتوح اللا محدود زمانيًا، حتى الوصول إلى تفاهمات حولها واعتمادها، ويستمرّ ذلك التطور، ما دامت الحاجة إليها موجودة.
بالرّغم ممّا تقدّم، يمكن القول بأن الوثيقة التي تم اعتمادها مبدئيًا، من جانب لجنة الحوار الوطني، ويجري طرحها للنقاش العام، تُعدُّ عملًا مهمًّا، وسوف تزداد أهميته مع استكمال المناقشات الجارية في حلقات متنوعة، يشارك فيها أشخاص آخرون، الأمر الذي يضمن لها مزيدًا من الموثوقية.
لقد حرّك مشروع وثيقة التفاهمات النقاشَ بين المثقفين السوريين بالفعل، وانخرطوا في تناول المصطلحات والمفاهيم السياسية والحقوقية-القانونية، فضلًا عن الاقتصادية والاجتماعية، وفي التدقيق بمدلولاتها، بعد أن كان التعاطي معها يجري باستخفاف إلى حدٍّ ما.
إن الحوار الجاري اليوم، وتعلّم النقاش والنقد الموضوعي حول الوثيقة، من دون التشهير بالمشروع، وبعيدًا عن إطلاق الاحكام المسبقة، يمكن أن يرقى بعملية الحوار، لأن تتحول إلى تمرين عقلي-فكري يمارسه المنخرطون فيه، وهذا هدف بذاته. فضلًا عن بلوغه هدف صياغة وثيقة معتبرة.
—————————-
قراءة في مشروع وثيقة توافقات وطنية/ علاء الدين الخطيب
أولًا: مدخل
أطلق مركز حرمون للدراسات مشروعًا واعدًا لإعداد وثيقة لتوافقات وطنية بين توجهات وتيارات سورية مختلفة. وقد قدّم نتائج المبادرة بوثيقة تحمل عمقًا في الرؤية وطموحًا محمودًا لمستقبل الوطن السوري، وفيها كثير مما يمكننا الجزم بأنه يشكل عروة وثقى لكثير من السوريين، وفيها أيضًا ما يزال يحتمل الاختلاف. وبالحصيلة، هي مشروع يستحق القراءة والتحليل وأيضًا النقد والتطوير.
أهمية هذا المبادرة من حيث المبدأ أنها تحاول وضع تصور أكثر وضوحًا لسورية المستقبل، وتجيب عن عدد من الأسئلة: كيف ستكون الدولة السورية؟ ما هي أسس إعادة بنائها بعد الخلاص من النظام الأسدي الدكتاتوري وحالة الفوضى المسلحة؟ ما هي بنيتها كمؤسسات وسلطات ونظام حكم؟ وعدد من الأسئلة التي تحتاج إلى تفصيل أكثر من الشعارات العامة المُجمع عليها التي قدّمها عدد من الجماعات المعارضة، من دون وضع مشروع طريق واضح وأكثر تفصيلية. فقدان هذا المرتكز كان له دور ليس مهملًا في جمود عمل مجموعات المعارضة السورية وفي زيادة تعقيد الوصول إلى حل في سورية، يجنبها مصير الحلول أو بالأصح التوافقات التي فُرِضت على العراق ولبنان ويوغسلافيا السابقة، التي لم تؤدِ إلى حلول قادرة على تأسيس دولة مستقرة قادرة على التطور المستدام[1].
في هذه الورقة، أناقش بضع نقاط وردت في الوثيقة التي أرى أنها تحتاج إلى تعديل أو إعادة نظر، وذلك من خلال الرؤية المستقبلية للدولة السورية المستقرة المهيّئة للتطور المُستدام، وتضمن لمواطنيها الكرامة والحرية والعدالة والمستوى المعيشي المناسب لمتطلبات العصر الحديث، وتضع سورية في مكانها الذي تستحقه على قطار التطور العالمي.
ثانيًا: مقدمة حول الوضع السوري
لا بد من تقرير بعض ما توافق عليه كثير من السوريين حول الوضع السوري، للتوصل إلى قراءة موضوعية لهذه الوثيقة ولرؤيتنا لمستقبل سورية التي يمكن تلخيصها بقراءة الأسباب التي أدت إلى استمرار تأزم الوضع السوري، والتحديات التي تواجه سورية المستقبل.
أسباب استمرار المأساة السورية وتعقدها
لعل هناك شبه إجماع على أن استمرار المأساة السورية وزيادة تأزمها واستعصائها على الحل يعود إلى أسباب كثيرة داخلية سورية، وخارجية دولية وإقليمية.
يتحمل النظام الأسدي المسؤولية الكبرى عن هذا الوضع، لأنه كان الأقوى بلا منازع في سورية حتى 2011، والطرف الذي تسبب في قتل أغلبية الضحايا السوريين أو تشريدهم أو سجنهم أو فقدانهم، والطرف الذي يتحمل مسؤولية أغلب التدمير في المستوى المادي والسياسي والوطني[2].
يلي ذلك من حيث المسؤولية الدعم المطلق الذي قدمته معسكرات إيران وروسيا ومعهما الصين للنظام الأسدي، وذلك بسبب ارتباط بقائه بمصالح استراتيجية عليا لهذه الحكومات ضمن الصراع العالمي[3].
كذلك فإن غياب الموقف والهدف الواضح للدول والحكومات التي أعلنت دعمها لمطالب الثورة السورية[4]، وغياب التنسيق في ما بينها، بل أحيانًا تصدير خلافاتها إلى الأراضي السورية، يجعل هذه الدول مشاركة في المسؤولية عن الحال السورية الحالية.
سيطرة قيادات الفصائل المسلحة على الداخل السوري، سواء كانت فصائل ممولة إيرانيًا وروسيًا وتدعم النظام الأسدي مثل حزب الله، أم كانت تدعي محاربة النظام الأسدي باسم الثورة؛ وكلا المجموعتين تعملان وفق شعارات طائفية وتحريضية زادت عمق المأساة في سورية.
أما في المرتبة الخامسة، فتأتي -بمسافة كبيرة عما سبق- مسؤولية هيئات المعارضة السورية الرسمية وغير الرسمية وجماعاتها التي كانت قادرة على العمل. فكل هذه الهيئات وقعت في أخطاء كبرى زادت صعوبة إيجاد الحل واستمرار المأساة السورية.
لعلّ أوضح هذه الأخطاء وأكبرها كان غياب أي عمل إعلامي منظم وواعٍ بالمشروع الوطني السوري، وشكل سورية المقبلة في وسط الصراع الدولي المتوحش، يحاول الاستفادة من حالة الاتفاق على رفض النظام الأسدي والتوافق على الأهداف الكبرى، لتشكيل جبهة شعبية موحدة وواعية وقادرة على صد التحديات والهجمات التي ركزت على تشتيت الشارع السوري وتفريقه. فلم يخرج أي مشروع إعلامي كبير يحاول مواجهة التشتت والانشقاق الذي عاناه السوريون تحت ضغط الإعلام والمعاناة اليومية، وغياب الوعي العميق بأسباب الصراع ومساراته داخل سورية وعليها.
التحديات الكبرى التي تواجه الحلّ المستدام في سورية
يمكن تصنيف هذه التحديات في تحديات دولية وإقليمية وتحديات داخلية سورية.
التحدي الدولي
أشرنا سابقًا إلى التحديات الدولية التي تتلخص بشراسة الصراع على أرض سورية، وأهميته في المستوى الدولي والإقليمي. وهذا الصراع يزداد تعقيدًا وصعوبة ولا سيما مع تفاقم الانقسام الدولي حول الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن ثم ربما يكون التعامل سوريًا مع هذا الصراع صعبًا جدًا، أمام قوة الأطراف الدولية والإقليمية وضعف الحال السورية. والسوريون الذين يريدون بناء سورية المستقبل، كدولة مستقلة موحدة تضمن كرامة مواطنيها وحريتهم ومعيشتهم وأمنهم، لا يمكنهم تحقيق ذلك بالتماهي الكامل مع مصالح هذا الصف أو ذاك من الدول المؤثرة، كما فعل النظام الأسدي بقبوله أن يضع سورية خط دفاع أول عن مصالح النظامين الإيراني والروسي[5]، ولا كما فعلت بعض هيئات المعارضة السورية، وكثير من قيادات الفصائل المسلحة.
لذلك، فالتحدي الدولي أو تحدي تعقيد الصراع الجيوسياسي الإقليمي والدولي هو تحدٍ صعب ومعقد جدًا، ومع ذلك لا بد للسوريين من امتلاك منظور سوري وطني يرى عمق هذا الصراع ومصالح الدول والحكومات، ويحاول بقدر الإمكان وضع سياسة توازن بين الطموح الوطني السوري وقانون الواقع الذي يفرضه الصراع الدولي والإقليمي.
التحديات السورية الداخلية
وتعني التحديات التي تواجه مستقبل سورية من داخل البنية السورية، سواء كشعب أم كتاريخ أم كموقع جيوسياسي، أم كمشكلات تقنية اقتصادية وإدارية ومؤسساتية. ويمكن تلخيص التحديات الكبرى الداخلية وفق ما يأتي:
التحرر من سطوة النظام الأسدي وقيادات الفصائل المسلحة بكل أنواعها، أي استقرار الوضع الأمني والعسكري على كامل الأرض السورية تحت حكم دولة واحدة. هذا المحور لا يدخل ضمن اهتمامات الوثيقة، لكنه يمثل الافتراض الأساسي للوثيقة ولرؤيتنا لمستقبل سورية، وهذه الرؤية تشكل حجر أساس لإيجاد حل مستدام[6].
الاستقطاب والشروخ الشاقولية، بين مكونات الشعب السوري. وهي ربما تكون أصعب التحديات التي تواجه سورية الجديدة، وبخاصة إن كان الحل الذي سيأتي على منوال ما حصل في لبنان أو العراق أو يوغسلافيا السابقة. هذا الاستقطاب تزايد وعُمق وفق تنوعات الشعب السوري، فظهر بالمشكلة الطائفية والقومية والسياسية، بمعنى الموقف السياسي مما يجري في سورية. هذه الاستقطابات أدت إلى تشتت السوريين في الموقف والرؤيا وحتى الموقف العاطفي، الذين بدورهم سيؤثرون في ضمان صلابة التعاقد الاجتماعي اللازم لبناء أساس قوي للدولة السورية المأمولة.
هذه الاستقطابات أو الشروخ، الطائفية والقومية والسياسية، كانت أداة وسلاحًا أساسيًا استخدمه النظام الأسدي منذ أول يوم في الثورة السورية، يوم ادعى رسميًا أنها حركات وتمرد طائفي؛ وكذلك استخدمه حلفاؤه، وبخاصة نظامي إيران وسورية. والمؤسف أن هذه الاستقطابات استُخدِمت أيضًا من بعض حكومات المنطقة، واستُخدمت دوليًّا أيضًا، لفرض ما يرونه من مصالح في سورية. وهنا كانت حركة هيئات المعارضة السورية والإعلام السوري المعارض مقصّرين بشكل كبير في التصدي لرد كل أشكال هذا التشتيت.
والأداة الأساسية في زيادة عمق هذه الشروخ وتأجيجها كانت الإعلام، بكل منصاته الكبيرة والصغيرة، وبخاصة أن هذه الاستقطابات تقدم تفسيرات سهلة، وتتناسق مع المرويات العامة السائدة في المنطقة ومع نظريات المؤامرة.
التحدي الطائفي، الذي يمثل أحد أهم هذه التحديات وأصعبها في مستوى تركيبة الشعب السوري. فالمشكلة الطائفية، بمعنى التمييز بين الناس وفق طوائفهم الدينية بصورة فجة معنويًا أو ماديًا، مشكلة موجودة في سورية تاريخيًا، مثل كثير من دول العالم. لكن النظام الأسدي خلال 40 سنة استغل هذا التنوع لزيادة الشحن الطائفي على مبدأ (فرّق تسُدْ). والعامل الأهم كان الفكرة الخاطئة التي سادت: أن نظام الأسد هو نظام علوي، وأن الثورة السورية ثورة سنّية، وبخاصة بربط ذلك مع سلاح التفسير الطائفي لعلاقات النظام الإيراني مع دول المنطقة، من خلال كونه نظامًا يدعي حمل راية الإسلام الشيعي الاثني عشري. وهذا التحدي يمكننا رصد خطورته في الحالة اللبنانية والعراقية، على الرغم من تشكيل ما يمكن تسميته دولة في كلا البلدين.
ظهر التحدي القومي بشكل أساسي ما بين القوميين العرب والقوميين الأكراد في سورية، على الرغم من أن بقية المجموعات القومية السورية لم تسلم أيضًا من هذه الاستقطابات. وتاريخ علاقة الأكراد السوريين وغيرهم من قوميات، مثل الآشوريين والسريان والعرب السوريين، تعود بسبب تأزمها الأساسي إلى مرحلة حكم حزب البعث لسورية بعد انقلاب 1963، ومن ثم سياسة الطاغيتين حافظ وبشار الأسد، وترتبط أيضا بمطالب الشعب الكردي الذي عانى الظلم في دول الإقليم، وبخاصة في المواجهة شبه المفتوحة مع الحكومة التركية.
أما الاستقطاب السياسي -وبخاصة ما بين ما يُسمى “مؤيد” و”معارض”- فقد تزايد بحدة، مع تزايد عدد الضحايا والتدمير والتهجير والشتات السوري، وتفاعل أكثر مع الخطابات الإعلامية التخوينية والإقصائية من طرف النظام الأسدي، وأيضًا من بعض أطراف هيئات المعارضة، من دون الأخذ بالحسبان طبيعة حركة المجتمعات البشرية في الأزمات الكبرى.
بالحصيلة، لا بدّ من التنبيه إلى أن حالة الاستقطاب التي أشرنا إليها هنا ليست حكرًا على السوريين، فهذه الاستقطابات بين مكونات الشعوب نراها في مختلف دول المنطقة، وعلى مستوى عالمي، حيث تتجلى في احتدام الصراع السياسي ما بين الحكومات في المنطقة والتيارات الإسلامية والتيارات الحداثية والتيارات القومية، كما تتجلى -عالميًا- في ارتدادات لليمين القومي، بل العنصرية الجديدة في عدد من الدول.
فشل الحركة السياسية المعارضة
هو التحدي الثالث الصعب أمام السوريين. فعلى الرغم من قبولنا بتبرير أن النظام الأسدي -طوال 40 سنة- منَع قيام حركة سياسية ديمقراطية تطوّر بنية حزبية سياسية وطنية؛ فإن شدة الأزمة ومرور أكثر من 12 سنة على اندلاع الثورة السورية لم تؤدِ إلى نشوء أحزاب سياسية حقيقية، تحمل رؤًى ومشروعات وخريطة طريق للمستقبل. فإلى الآن، لا نكاد نرى -السوريين- سوى عمل التيارات الإسلامية السياسية، وبالكاد نلحظ حركة سياسية مقابلة في التيار الديمقراطي العلماني. وفي كلتا الحالتين، باستثناء حركة الإخوان المسلمين، لا توجد أحزاب كوّنت الحد المقبول من النضج السياسي، لطرح نفسها كأحزاب سياسية تناسب الدولة الحديثة المأمولة.
التحدي الاقتصادي
على الرغم من أنّ الاقتصاد السوري كان في حالة سيئة جدًا، غداة انفجار الثورة السورية، فإن 12 سنة من الحرب والعنف المتطرف الذي مارسه النظام الأسدي وحلفاؤه من دول وميليشيات، إضافة إلى عنف الميليشيات التي حملت راية محاربة الأسد لكنها مارست حرب ميليشيا عمليًا، وإضافة إلى قرارات المقاطعة الاقتصادية للنظام السوري، والأزمات الاقتصادية العالمية التي ما زالت تعصف بالعالم، زادت الوضع سوءًا؛ فالنتيجة هي دمار أكثر من ثلثي البنية التحتية الاقتصادية في سورية، وانهيار الاقتصاد والعملة السورية، فضلًا عن عمليات السلب والسرقة الكبرى التي نالت الموارد السورية. وبناء على ذلك، فإنّ إصلاح الوضع الاقتصادي أمام هذه الكارثة الاقتصادية، مع وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري خارج سورية وأكثر من 5 ملايين مشرد ضمن سورية، هو تحدّ كبير وصعب ومعقّد، خصوصًا مع ضبابية الموقف الدولي من شكل سورية المستقبل.
التحدي المعنوي والتوعوي
إن آثار 12 سنة من الحرب والتهجير والشتات والفقر والظلم والخسائر، وبلوغ جيل كامل من السوريين خلال هذه المرحلة لم يعرف سوى واقع الحرب والخوف والمعاناة وحرب الإعلام والاستقطاب، تفرض تحديًا هائلًا على الدولة السورية الجديدة، وهو تحدٍ لا يمكن الاستهانة به، وبخاصة أن الجيل الجديد لا يعرف ماذا ولماذا، والجيل الأكبر مثخن بالجراح والآلام.
التحدي السياسي
دعا عدد من المشروعات السورية إلى إطلاق دعوات لرؤية موحدة لسورية الوطن، وهذا بالتأكيد مطلب سليم ووسيلة صحيحة لضمان وحدة الوطن السوري. لكن محاولة تجميع الرؤى كلها لمستقبل سورية، كدولة ونظام ومؤسسات، عملية شبه مستحيلة كما أثبت الواقع السوري وواقع دول الربيع العربي ودول العالم، وبخاصة أن الرؤى السياسية السورية ما زالت موزعة بين تيارات مختلفة. فالتيار الإسلامي السياسي موجود وقوي، وكذلك التيار الديمقراطي العلماني؛ وأيضًا توجد تيارات سياسية قومية عربية وكردية. فهذه الاختلافات بالتوجهات تجعل وضع مشروع موحَّد لسورية المستقبل عملية صعبة تحتاج إلى بعض التنازلات الضخمة، لأنها، بدون هذه التنازلات، لا تستطيع تغيير حكم الأمر الواقع الذي يفرض أن الجمع بين المختلفين عملية غير مضمونة النتائج، في السياق السياسي لحكم الدول المستقرة، فضلًا عن إطلاق عملية إعادة بناء وتأسيس للدولة. وقد رأينا هذه المحاولات في العراق ولبنان، وشهدنا أنها بالمحصلة لم تصل إلى الحد الأدنى مما كان يتمناه الشعبان العراقي واللبناني. ولذلك فإن هذا التحدي السياسي قد يفرض على الواقع السوري إطلاق عدة مشاريع ورؤى لسورية المستقبل، تتفق على بعض الأهداف العامة الكبرى، وتتنافس فيما بينها لإقناع السوريين والقوى المؤثرة في الوضع السوري.
ثالثًا: وثيقة التوافق الوطني
تقدم الوثيقة مشروعًا وطنيًا متكاملًا إلى حد كبير، ويمكن رؤيته كمشروع للدولة السورية المنشودة عند الخلاص من صناع الحرب والاقتتال، ابتداء بالنظام الأسدي والفصائل المسلحة الفوضوية. وقد أحاطت وثيقة التوافقات الوطنية بكثير من الأسس الضرورية واللازمة كي لا تقع سورية في حالة فوضى وإعادة إنتاج للأزمة، كما حصل -مع الأسف- في التجربة العراقية واللبنانية، لكن كأي مشروعٍ أو طرحٍ في هذا المستوى من الأهمية، التطوير والنقد مطلوبان وضروريان، وأورد هنا أهم الأفكار التي أرى أنها بحاجة إلى النقد أو الإضافة.
نقاش ما ورد في الوثيقة
العلمانية والعلمانية اللينة
أكدت الفقرة (ش) في وثيقة المبادئ أن العلمانية خيار ضروري وأساسي في سورية الجديدة، وأنها شرط لازم يتوافق مع الديمقراطية ودولة المواطنة؛ لكنها أيضًا استخدمت تعبير “علمانية لينة خاصة بالسوريين”. وهنا نجد أن التعبير المطروح قد يشكل خطرًا على العلمانية المنشودة نفسها، وعلى الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. فالعلمانية الليّنة هي محض تنظير سياسي وفكري عربي، لا يوجد مقابل عملي تطبيقي له في العالم، ومن ثم، كما يحدث في دول العالم كلها، فالقوانين والأسس الدستورية تكون عرضة دائمًا للتفسيرات المتعددة. ومع قوّة التيار الإسلامي السياسي، في دول المنطقة ومنها سورية، ومع مناهضة أغلب الحكومات القائمة والإعلام للعلمانية، فإن اجتراح تفسيرات تضرب العلمانية بأساسها سيكون معضلة سريعة الانفجار في المراحل الأولى، كما حدث في مصر، حين أطلق الإخوان المسلمون مصطلح الدولة المدنية بديلًا غير صحيح للعلمانية.
العلمانية بشكلها التطبيقي في كثير من دول العالم هي فصل سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية عن التشريعات الدينية وسلطة رجال الدين، وأيضًا حماية أديان الناس وعقائدهم وحرياتهم بالتدين والإيمان وممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون أي تمييز[7]. وهذا النموذج معمول به في كثير من الدول المختلفة، ثقافيًا وتاريخيًا واجتماعيًا، ومنها دول ذات أغلبية مسلمة مثل تركيا.
فالسؤال هنا: ما هي النقاط اللازمة للعلمانية، مقارنة بالدول العلمانية الديمقراطية في العالم، التي ستتصادم مع ثقافة السوريين أو بيئتهم، والتي قدّمتها الوثيقة مبررًا لاجتراح مفهوم العلمانية اللينة؟
بالتأكيد، لا يمكن قبول تحديد دين الدولة أو الرئيس أو الشخصيات القيادية في الدولة، كما هي حال سورية وأغلب الدول العربية خلال العقود الماضية. ولا يمكن أن يكون إبقاء فقرة أن الشريعة الإسلامية أو المسيحية أو مبادئهما تشكل مصدرًا أو المصدر الأساسي للتشريع في الدولة، كما هي حال دول المنطقة. لإن إقرار أي من هذين المبدئين هو بالواقع ضرب للعلمانية في جوهرها، ومن ثم تهديد للديمقراطية وللدولة ذاتها.
وإن كان المقصود ما يُشاع حول أن العلمانية تحارب الدين ذاته، فإن حوالى خمسة ملايين سورية وسوري في تركيا وأوروبا قد شهدوا بعيونهم بالممارسة اليومية أن الدول العلمانية الديمقراطية لا تحارب الدين في هذه الدول، بل بالعكس تحمي الحرية الدينية للجميع على قدم المساواة.
أما مشكلة ما هو سائد حول أن الشارع السوري سيرفض العلمانية، لأن سمعتها قد شُوّهت، فبغياب الدراسات الاستطلاعية والإحصائية؛ يمكننا الجزم بأن هذا التقديرات مبالغ بها جدًا. بالتأكيد ستجد العلمانية معارضة وقبولًا، لكن لن يكون للطرف المعارض تلك الأرجحية الواضحة والكبيرة، لأسباب كثيرة أوردتها بورقة منشورة لدى مركز حرمون تناقش هذه الادعاءات وتنقدها[8].
إن الوضوح بطرح العلمانية، كأساس ضروري مع الديمقراطية والأخذ بشرعة حقوق الإنسان الدولية، يتماشى مع النموذج الأصحّ للدولة الحديثة السورية التي يجب أن تكون شفافة وواضحة بقدر الإمكان أمام الشعب وببنيتها المؤسساتية. وإن العلمانية بوصفها مبادئ هي أداة لا غنى عنها في محاولة معالجة جروح الماضي التي رُسِّخَ أنها ناتجة من التنوع الطائفي الديني السوري. ولا يمكن ذلك من دون أساس علماني يرى أن المواطنين متساوون تمامًا، ليس فقط من حيث الحقوق والواجبات، بل أيضًا من حيث الوطنية والانتماء والأخلاق، من دون أي تمييز وفق الدين أو الطائفة.
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
ورد في النقطة (أ) من الفقرة الثالثة، من الوثيقة الموسعة حول حقوق الإنسان، أن الدولة السورية تتبنى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوثائقها الثلاث وتكرسها قانونيًا ودستوريًا. لكن في النقطة (ب) من الفقرة نفسها، ورد أن الدولة ستعالج مسألة تعارض بعض تلك الحقوق مع ثقافة المجتمع وقيمه السائدة.
وهنا أيضًا هذا الاقتراح يفتح الباب لفقدان الفقرة (أ) أهميتها ومدلولها، وقد يعيدنا إلى الحالة نفسها التي تعيشها الدول العربية أغلبها التي تذرعت بالخصوصية.
بواقع الحال، إن أغلبية الأصوات التي تحتج على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تتجه إلى معارضة المبادئ التي تحمي حقوق المرآة بشكل أساسي، وحماية الحرية الدينية والاعتقادية للناس. وفي كلتا الحالتين، الدولة السورية الحديثة تحتاج إلى وضع حقوق المرأة ودعمها للوصول إلى المساواة الكاملة مع الرجل كمواطن وإنسان، هدفًا أساسيًا يضمن استقرار المجتمع وازدهاره، وكذلك فإن الحرية الدينية والاعتقادية أصبحت مبدأً لا يمكن التنازل عنه في الدولة الحديثة.
وهنا، ربما يظهر التعارض في سؤال قوانين الأحوال الشخصية، مثلًا. والحل واضح وعملي ومطبق في تركيا ذات الأغلبية المسلمة، وفي أغلب الدول العلمانية الديمقراطية. ففي هذه الدول كلها، القانون الحاكم هو القانون المدني للأحوال الشخصية، ويترك حرية الالتزام بالتشريعات الدينية في الزواج والطلاق وغيرها للأشخاص، إن توافق الأطراف كلهم عليها برضاهم؛ فمثلًا، شهد حوالى خمسة ملايين سوري في تركيا وأوروبا أنه يمكنهم الزواج وفق الشريعة الإسلامية أو المسيحية، وأن يسجلوا الزواج لدى الدولة مدنيًا، وهذا حل يضمن حقوق الجميع.
حتى في القضايا الأكثر إشكالية، مثل الزواج المتعدد أو بعض قوانين الإرث التي تميز بين الذكر والأنثى، فإن الدولة الحديثة لا بد لها من قوانين تنهي هذه الحالات، وبخاصة أنها ليست مكونًا عقائديًا، بل اجتهادات فقهية. وهي أيضًا حال تركيا وحال المسلمين الذين توافقوا مع القوانين في الدول الغربية. وعمليًا، يمكننا الزعم أن الواقع العملي يقول إن الزواج المتعدد في انحسار نسبي بطبيعة الحركة الزمنية التطورية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الإرث ليست تعارضًا مع التشريع الديني.
وهنا، لا بد من التأكيد أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تمثل حزمة متماسكة من الحقوق التي لا يمكن التخلي عن أحد مبادئها، وإلا فقدت قيمتها، وفتحت المجال للتخلي عن مبادئ أخرى. وهذه المبادئ تمثل الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية التي تطمح إليها الإنسانية، ومع ذلك، فما زالت تصطدم بكثير من المعوقات حتى في الدول الأكثر اقترابًا من تطبيق هذه الحقوق.
شكل الدولة السورية ما بين المركزية واللامركزية الإدارية
دعمت الوثيقة بالفقرة 7 شكل اللامركزية الإدارية، وقدمت من الأسباب والمبررات ما يفي بضرورة تبنيها في سورية الجديدة. لكن ما لم تلحظه الوثيقة أن الدولة في المرحلة الأولى من إعادة البناء ستحتاج إلى سلطة مركزية أكثر قوة من المشار إليه، وأهم سبيين يستدعيان هذه المرحلة الانتقالية في الحكم هما:
ستكون سورية بحاجة إلى قرارات مركزية في المستوى الاقتصادي، لمباشرة عملية إعادة البناء إعادة متوازنة تأخذ بالحسبان الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، ومدى الدمار في المناطق المختلفة من سورية، وفي الوقت نفسه تتحمل مسؤولية وضع الأولويات بعملية إعادة البناء ما بين نوع المشروعات وأماكنها.
ستحتاج عملية إعادة ترميم الجراح المعنوية والنفسية، ومعالجة الشروخ الطائفية والقومية والسياسية ما بين السوريين، إلى رؤية سورية موحدة تجمع بين الرؤى السورية من خلال الحكم المركزي.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون هدف الوصول إلى شكل الحكم اللامركزي المشار إليه في الوثيقة قائمًا دائمًا، وموضوعًا وفق جدول زمني محدد لا يحتمل التأخير، وهذا يمكن أن يتم من خلال وضع خريطة طريق وطنية شاملة، كما سنبين في الفقرات اللاحقة.
النموذج الاقتصادي والاجتماعي في سورية
المبادئ المطروحة مبادئ حديثة، وهي تتوافق مع متطلبات الازدهار الاقتصادي عمومًا، ولا جدال أن اقتصاد السوق الحرّ هو المسيطر عالميًا ولا بد من الأخذ بمبادئه. لكن تجب مراعاة أن سورية تخرج من حرب مدمِّرة قضت على ثلثي البنية التحتية، وأن ما تبقى من بنية تحتية هي بنية متهالكة وغير قابلة للاستخدام الفاعل، ومن هنا، فإن دور الدولة أو القطاع العام سيبقى أساسيًا، على الأقل للاضطلاع بمهمة بناء البنية التحتية التي ستحتاج إلى استثمارات وجهد هائل، وستشكل الهيكل العظمي الأساسي لاقتصاد سورية المستقبلي.
فوفق تجارب أغلب دول العالم، ومنها كثير من الدول الغربية؛ لا يمكن لسوى الدولة تحمّل مسؤولية بناء البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والسكك الحديدية والنقل العام وشبكات الكهرباء والمياه والنظام التعليمي المجاني المتاح للجميع. وهنا نذكر بالإخفاقات الكبيرة التي وقعت فيها دول صاعدة اقتصادية، بسبب تراجع دول الحكومات أمام القطاع الخاص، وبخاصة مع تنازلها لشروط الدول الغنية والبنك الدولي.
أي إن الشكل الأقرب للنهوض بعملية البناء هو شكل الاقتصاد الاشتراكي الاجتماعي المتبع في دول أوروبا الغربية، وهو الشكل الذي بنى هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية. لكن مع ذلك فإن عددًا من دول أوروبا الغربية يعاني مشكلات اقتصادية مستمرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وأحد أهم أسبابها هو التوسع في التخصيص ومنح الشركات الكبرى امتيازات متزايدة، ما أدى إلى تراجع الخدمات التي اعتادت هذه الدول تقديمها لمواطنيها في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فلنا أن نتوقع ما يمكن أن يؤدي إليه نظام النيو-ليبرالية الاقتصادية، في دول تعيد بناء ذاتها تقريبًا من الصفر مثل الحال السورية.
كذلك لا بد من الاستفادة من تجارب دول عانت أزمات كبرى، مثل العراق ولبنان ويوغسلافيا السابقة، حيث فشلت أغلبية تجارب إعادة البناء وتأسيس دول قوية اقتصادية في هذه الدول. بل إن اتباع دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لنمط النيو-ليبرالي الاقتصادي أدى إلى فشل اقتصادي واضح في هذه الدول، بعد ثلاثة عقود من الخلاص من الحكم الشيوعي الشمولي.
وهنا، لا بد من تأكيد أهميّة أن تُعدّ إعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والخدمية في سورية، وفق النماذج الحديثة المستدامة، حجر الأساس الذي لا غنى عنه لضمان الازدهار الاقتصادي اللازم لدعم استمرار الدولة السورية؛ فكثير من الدول الصاعدة اقتصاديًا، على الرغم من ازدهارها الاقتصادي نسبيًا، ما تزال بنيتها التحتية لا تضمن لها استمرارًا وزخمًا مستقبليًا، مثل السعودية وتركيا، حيث إننا لا نجد مثلًا خطوطَ سكة حديدية تغطي المساحات الشاسعة، ولا حتى ما يكفي من خدمات نقل عام ضمن المدن الكبرى. بل حتى الولايات المتحدة تقف أمام تحد اقتصادي كبير بسبب تآكل بنيتها التحتية الخدمية.
نقاش لما يمكن إضافته إلى الوثيقة أو إلحاقه بها
غطت وثيقة التوافقات الوطنية كثيرًا من المبادئ والأسس الضرورية لسورية الجديدة، مع ذلك فإن المشروع، بوصفه رؤية مستقبلية للدولة السورية، يمكن أن يزداد تكاملًا بإضافة بضعة نقاط بالأهمية نفسها.
المبادئ فوق الدستورية
أشارت الوثيقة إلى المبادئ فوق الدستورية التي وضعتها تحت مُسمى القواعد الدستورية المحصنة، وأطّرت لطرح المبدأ بما يلبي حاجات الدولة السورية الجديدة.
ويمكن هنا اقتراح بعض المبادئ المطلوبة والضرورية لضمان قيام الدولة السورية الحديثة التي تستطيع الاستمرار، كإطار مؤسساتي حاكم ضمن هذا التطور؛ وهي مبادئ مستوحاة من الوثيقة يمكن تلخيصها بهذه النقاط بوضوح وتحديد:
سورية دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتنوع البشري.
المواطنون السوريون كلهم يحظون بالحقوق والواجبات نفسها، من دون أي تمييز قومي أو ديني أو طائفي أو سياسي أو جنسي.
شرعة حقوق الإنسان الدولية بوثائقها الثلاث تشكل مرجعًا دستوريًا، إضافة إلى الدستور السوري.
سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية مستقلة عن التشريعات الدينية.
الدولة تضمن حرية الرأي والاعتقاد والتديّن والتعبير لكل المواطنين، بما لا يناقض الدستور والقانون.
لا يجوز تشكيل أحزاب سياسية قائمة على أساس قومي أو ديني.
لا يتحمل أي مكون سوري ذي صبغة دينية أو طائفية أو قومية أو مناطقية مسؤولية ما حصل في سورية من مأساة، ولا يُسمح بأي تحريض وتجييش أو حملات كراهية ضد أي من هذه المكونات.
دور الإعلام والإعلام البديل
أصبح الإعلام خلال العقود الثلاث الماضية من أقوى المؤثرات والأسلحة المستخدمة في مستوى العالم والدول في الصراعات السياسية، وأداة أساسية في تحقيق السلام، وأيضًا في ضرب الوحدة الوطنية وتجييش الشعوب نحو الاستقطاب. هذا التغيير في طبيعة البنية الجيوسياسية للعلاقات الدولية، وضمن الدول نفسها، وأيضًا في تركيبة عمل الاقتصاد والسوق وآلياته، يعود إلى الأسباب الأساسية الآتية:
انتهاء الحرب الباردة، وسيطرة اتفاقات تحرير التجارة وحرية حركة رؤوس الأموال، وسيطرة النيو-ليبرالية الاقتصادية على كثير من دول العالم، وتراجع دور الحكومات المركزية وسلطتها.
انتشار الإنترنت وسيطرة الإعلام البديل، أي منصات التواصل الاجتماعي، وبذلك سيطرة الفوضى في المعلومات والإعلام.
فشل النخب السياسية التقليدية والثقافية في كثير من دول العالم.
وفي سورية، خلال 12 سنة، استُخدِم الإعلام الكبير -من فضائيات وصحف، والإعلام البديل في مستوى منصات التواصل الاجتماعي- في حرب التحريض الطائفي والقومي والسياسي، وفي تشتيت الشارع السوري. هذا الإعلام لم يكن مقصورًا على القنوات السورية، بل أيضًا كانت ظاهرة واضحة بالإعلام العربي والأجنبي.
بالمقابل، لم يخرج أي مشروع إعلامي بإمكانات معقولة لمواجهة هذه التيارات التحريضية، ولا لمواجهة الشروخ السياسية والطائفية والقومية التي أصابت الشارع السوري. في الواقع، كان هناك إما تساير مع التيار السائد المسيطر إعلاميًا، أو انكفاء للخلف عن مواجهته.
لعل مشروع الوثيقة لا يرى أن هذا الطرح من اختصاصه، لكن واقع القرن الحادي والعشرين، وطبيعة حركة الأسواق والمعلومات والإعلام، يفرضان أن يكون المشروع الإعلامي الوطني مشروعًا ذا أولوية كبرى.
وهنا نشير إلى التجربة في أوروبا الغربية، حيث باشرت الحكومات بحمل راية الإعلام الحامي للقيم والحقوق والمجتمع، وآتت هذه السياسة ثمارها بوضوح، مقارنة بسيطرة الإعلام الخاص على الإعلام الأميركي. وكثير من الباحثين في ظاهرة صعود اليمين الغربي المتطرف يضعون بين أسباب هذه الظاهرة تراجع الإعلام الممول حكوميًا وتقليديته. وليس المقصود هنا الإعلام الحكومي الذي اعتدناه في سورية ودول المنطقة، بل الإعلام الممول من الدولة الذي لا يرى الربح التجاري الكبير هدفًا أساسيًا، وفي الوقت نفسه، يتقن لعبة الإعلام وأساليب الوصول إلى الناس، والجمع ما بين الطرح الهادف والمتعة والجذب. وهذه المهمات لن يتصدى لها الإعلام الخاص، كما تثبت تجربة دول العالم كلها، لأنها مهمات لا تقدّم ما يسعى إليه الإعلام الخاص من مرابح. ولا يجب أن تقتصر مهمة الإعلام على معالجة الشروخ بين السوريين والجروح النفسية والمعنوية، بل يجب أن تساعد في نشر ثقافة الحوار والاختلاف، وبخاصة أن الأسئلة ستكون كثيرة، والإجابات عنها ستتنوع وربما تتناقض.
خريطة طريق استراتيجية
الفرق الأساسي بين الدول المتقدمة الصاعدة، والدول النامية التي ما زالت تعاني بطءَ التنمية ومشكلات الاستقرار، هو وجود تخطيط استراتيجي قريب المدى ومتوسطه وبعيده. هذا نوع من التخطيط المستقبلي أصبح ضرورة لبناء الدولة الحديثة، وهو حقل بحثي علمي وسياسي حديث نسبيًا.
خريطة الطريق المطلوبة بحاجة إلى رؤيةٍ للواقع السوري بعد انتهاء الاقتتال وسيادة الأمن مبدئيًا، تنطلق من معطيات الواقع الوطني الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية والإعلامية، ومن معطيات الواقع الإقليمية والدولية؛ ثم توضَع خريطة طريق لمختلف المسارات المذكورة وفق مراحل زمنية متدرجة:
المدى القريب: مثلًا خمس سنوات، وتمثل مرحلة حرجة تحمل مطالب وأهداف ضخمة وصعوبات هائلة، وتمثل مرحلة التأسيس لبنية الدولة مؤسساتيًا، وإطلاق المشروعات الكبرى الاقتصادية الملحّة، وبدء إعادة معالجة الجروح في المستوى البشري.
المدى المتوسط: مثلًا خمس عشرة أو عشرين سنة، وتمثل مرحلة استمرارية للوصول إلى مستوى جيد من الاستقرار والتطور وتحقيق الأهداف القريبة على الصعد كلها.
المدى الطويل: مثلًا أربعين أو ستين سنة، وتمثل مرحلة النهوض الحقيقية لتطور الدولة والمجتمع.
ميزة هذه المراحل الزمنية في التخطيط أنها تجنب الدولة الوقوع في أخطاء إعادة البناء المتسرعة التي لا تضع بالحسبان المدى الزمني الطويل، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية.
وهذه المراحل الزمنية ضرورية أيضًا في رؤية شكل سورية المستقبلي خلال بضعة عقود، كما يأمل السوريون ويطمحون في المستويات السياسية والسلطوية والتربوية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى المستوى الاقتصادي، كما يبين الشكل 1.
الشكل 1، خريطة طريق وفق ثلاث مراحل زمنية لوضع استراتيجية إعادة البناء وفق سيناريوهات مبنية بناء علميًا وموضوعيًا.
من الناحية الاقتصادية، أصبح هذا التخطيط المستقبلي ضرورةً لأي دولة حول العالم. وفي بلد خارج من دمار هائل، كما حصل في سورية، يستجيب هذا التخطيط لتحقيق أكبر المرابح مع ضمان أفضل نتائج كمية للاستثمارات المطلوبة.
وكما أشير في فقرة شكل الدولة السورية، فإن تطوير بنية الدولة السورية نحو دولة ذات نظام حكم لا مركزي إداريًا، يضمن قوة الدولة وحقوق المواطنين، ويتماشى مع التخطيط الاستراتيجي المطروح.
رابعًا: خاتمة
إن العمل المنظّم والواعي الذي قام به مركز حرمون يستحقّ الثناء والشكر، لكنه يحتاج إلى الاهتمام والمتابعة والتدقيق، للوصول إلى صيغة وطنية سورية تتماشى مع الآمال السورية في دولة مستقرة متطورة ضامنة لحقوق مواطنيها وحقوقها بوصفها دولة. ولعل الصعوبة الأساسية تبقى في الجمع ما بين مختلف الرؤى الموجودة بين السوريين، ولعل النتيجة التي تعلمناها، نحن السوريين، مثل كثير من بلدان الربيع العربي ودول العالم، أن محاولة الجمع بين الرؤى المختلفة وأحيانًا المتناقضة هي مهمّة شبه مستحيلة. لذلك فإن انحياز المركز -كمؤسسة بحث علمي- إلى إحدى الرؤى لن يؤدي إلى شقاق حقيقي، بقدر ما سيقدّم هذه الرؤى وفق منهجية علمية موضوعية.
[1] قضية بعنوان الدولة الديمقراطية العلمانية هي الخطوة الأساسية للحلّ في سورية، علاء الخطيب، مركز حرمون للدراسات، تاريخ 05/10/2021، https://bit.ly/3HDgtpG
[2] توثيق تاريخي بعنوان Syrian Civil War، الموسوعة البريطانية، تاريخ آخر تحديث 04/05/2023، https://bit.ly/3nvOBwG
[3] دراسة بعنوان الصراع الدولي والأزمة السورية: الأسباب والنهايات، علاء الخطيب، مرصد مينا للدراسات، تاريخ 01/09/2018
[4] دراسة بعنوان السياسة الأميركية ليست في حاجة إلى حسم الأزمة السورية، علاء الخطيب، مركز حرمون للدراسات، تاريخ 11/06/2016
[5] مقال بعنوان بشار الأسد: سوريا هي خط الدفاع الأول عن إيران وروسيا، علاء الخطيب، موقع بيت السلام، تاريخ 18/10/2016
[6] – مقال بعنوان شكل سوريا القادم هو بداية الحل، علاء الخطيب، موقع بيت السلام، تاريخ 07/10/2016، https://bit.ly/3LM34N0
[7] – ورقة بعنوان ما هي العلمانية، علاء الخطيب، موقع بيت السلام، تاريخ 08/10/2016، https://bit.ly/3NYuzpB
[8] – قضية بعنوان هل العلمانية هي ذلك الغول الذي يرفضه العرب والسوريون؟، علاء الخطيب، مركز حرمون للدراسات، تاريخ 08/12/2021
————————-
ملاحظات نقدية حول “مشروع وثيقة توافقات وطنية”/ محمد حبش
الإخوة الأعزاء في مركز حرمون للدراسات المعاصرة
أشكر لكم مشاركتي وثيقة التوافقات الوطنية التي أعدّها فريق إدارة الحوار في مركزكم، والتي استخرجت من “التقرير العام للحوار الوطني” الذي تضمن خلاصات جميع الحوارات التي شاركنا فيها في اللقاءات الكريمة مع الفريق، وآمل أن أقدّم ما هو مفيد وجديد.
سأركز ملاحظتي على عدد من المسائل:
في وثيقة الأسس والمبادئ:
ج- تعمل سورية على تعزيز علاقاتها الإيجابية مع الأسرة الدولية.
تجدر الإشارة إلى تنمية العلاقات بشكل خاص مع الدول الديمقراطية، والناجحة اجتماعيًا واقتصاديًا، وبناء الشراكات الإيجابية معها، وتجنب الدخول في تحالفات أو شراكات مع الدول الاستبدادية والدكتاتوريات، فقد أضرت هذه التحالفات كثيرًا بالواقع السوري، وكانت سببًا رئيسًا لتفاقم الكارثة السورية والإساءة إلى الوحدة الوطنية وتشميل سورية بمشروعات استبدادية إقليمية ودولية.
ويتعين اعتماد صيغة قانونية يقرّها البرلمان باستمرار، لتحديد الدول التي تحظى بالأولوية في العلاقات الدولية، والدول التي يشكل التحالف معها مخاطر على الشعب وقيم حقوق الإنسان.
ف – القواعد الدستورية المحصنة
وردت كلمة قابليتها “للتجميد”، وهي كلمة غير واقعية وغير دستورية أيضًا، والأصح التعبير بأنها مستقرة وراسخة لا يمكن للنظام الحاكم تعديلها بإرادة مؤسساته، بل يتطلب تعديلها استفتاءً شعبيًا حقيقيًا بإشراف دولي.
في مشروع وثيقة التوافقات الموسعة:
القواعد الدستورية المحصنة
كُرّرت العبارة السابقة، حيث وردت هنا في فقرة ج: “قابليتها للتجميد، بحيث لا تصطدم بحركة المجتمع وحاجته إلى التطور”. ويبدو أن الخطأ هنا لفظي، بحيث يكون المقصود قابليتها للتجديد لا للتجميد، وإذا كانت كلمة التجميد مقصودة، فأنا أعترض عليها، شكلًا ومضمونًا، وأطالب بتعديلها كالآتي:
رسوخها واستقرارها وقابليتها للتجديد وفق أسس قانونية صارمة، بحيث لا تصطدم بحركة المجتمع وحاجته إلى التطور.
سيادة القانون في سورية الجديدة
أؤيد بشدة ما ورد في الوثيقة من ضرورة النص دستوريًا على سموّ الاتفاقات والمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية، ويتعين النص أيضًا على وجوب الانخراط في الإجماع الدولي ومنع السلطة من القيام بحملات ممنهجة لتشويه الأسرة الدولية وتخوينها، وهي السلوك الذي أدى إلى عزلة سورية في العالم، وجعل الجواز السوري في القاع.
الحقوق والحريات في سورية الجديدة
يجب إطلاق الحريات إلى الغاية وحمايتها، وبخاصة في الشأن التشريعي، ومع ذلك لن يكون من الواقعي ولا المنطقي حذف المواد الدستورية المتصلة بدور الشريعة الإسلامية في التشريع، وذلك لأنها من الجهة الواقعية القانون التاريخي للبلاد السورية، وهي مستقرة في وجدان الناس، وعادة ما تنص الدساتير بكل أشكالها على الاحترام والتقدير للنصوص الدستورية السابقة والبناء عليها.
ولكن ينبغي أن تقوم سورية الجديدة ببذل جهد استثنائي في تقديم نموذج متقدم من الوعي الإسلامي في مسألة الحريات، وذلك اهتداء بالنماذج المتقدمة التي حققتها دول إسلامية رائدة في الجمع بين المختار من الشريعة وحاجات العصر التشريعية.
شكل الدولة في سورية الجديدة:
أوافق على التعبير بصيغة اللامركزية الإدارية الموسعة، ولكنني مع توفير مزيد من الضمانات للمحافظات التي عانت مخاطر جدية، وخصوصًا المنطقة الكردية، حيث تعيش الطائفة الإيزيدية التي تعرضت بصورة غير مسبوقة لشكل متوحش من الإبادة والسبي، وقد فشل الجيش المركزي فشلًا تامًا في حماية هذه الأقلية المستهدفة بسبب عقيدتها وموروثها.
ويتعين تأكيد حماية الثقافة واللغة الكردية السائدة في الشمال السوري بوضوح، وعدّها لغة رسمية ثانية في هذه المحافظات، واحترام أهل المنطقة في حماية ثقافتهم ولغتهم.
ويتعين توفير قوة عسكرية محمية بالدستور مخصصة لحماية المنطقة ضمن تنسيق مع قيادة الجيش السوري، تخصص باستمرار لتوفير الحماية الكافية لهذا الجزء العزيز من أبناء الوطن.
وكذلك تتعين حماية الثقافة الأشورية والسريانية، حيث وجدت في سورية، وتخصيص كراسي أكاديمية لحمايتها في الجامعات السورية، وإدارة خاصة في وزارة الثقافة.
ويتعين وقف التلويح المستمر بتعريب سكان البلاد، وعدّ جهد التعريب القسري أعمالًا غير دستورية تتناقض مع حقوق الإنسان ويحاسب عليها القانون.
المسألة الطائفية:
في المسألة الطائفية، انتهى المتحاورون إلى نتائج مهمة تنأى بسورية الجديدة عن الجحيم الطائفي الذي عاناه الناس وما يزالون نتيجة سياسات استفزازية خاطئة مارسها النظام، وقد ووجهت بردّات فعل عنيفة ومدمرة من التيارات الأصولية.
أعتقد ان الجانب الأساسي في العلاقة مع المسألة الطائفية هو الاحترام، فقد عمد النظام تاريخيًا إلى انتهاج أسلوب طمس الهوية، وفرض نمط واحد على الشعب في الإطار الديني والمجتمعي والهوياتي، الأمر الذي وفر قدرًا مؤلمًا من التنمر على الطوائف واحتقار المذهبيات وتصاعد خطاب الكراهية.
ويتعين أن تعرّف الدولة بأجهزتها القانونية والتعليمية والثقافية والإعلامية والبلديات بمكونات الشعب السوري باحترام، والتعريف بطوائفه نشوءًا ورجالًا وقيمًا ومبادئ، وتخليد رموزه وأوابده بتقدير واضح، وتكريس ذلك في المناهج التعليمية، والتغيير الجذري للسلوك السابق القائم على رفض الاعتراف بالهويات المجتمعية.
وينبغي رصد كل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية، وأن يشرع قانونيًا منع التمييز والتنمر على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي.
إن ما آمله في سورية الجديدة هو تأسيس مجلس للتلاحم المجتمعي يتولّى حماية القيم التاريخية للشعب السوري، والترويج للقيم الفاضلة في كل طائفة والتعريف برموزها وأعلامها ومساهماتها، وإحياء أدوارهم في المجتمع، وبخاصة أولئك الذين شكلوا إجماعًا وطنيًا وإنسانيًا.
إن الهوية الصغيرة لا تلغي الهوية الكبيرة، وهوية الطائفة أو المذهب لا تلغي الانتماء الوطني، إن ذلك مثلًا يتم بشكل عادي تمامًا في الأسرة السنية، على الرغم من التوزع بين المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وكذلك الصوفية والسلفية، وهي لا تدرس في جوّ من الشحناء والأحقاد والريب، بل في جو من إدراك جمال التنوع وعذوبته وقدرته على تلبية حاجات الناس، وإيقاظ المعاني الجميلة فيها.
ولكن الأمر يتخذ طابعًا تحقيريًا، عندما يتجاوز حدود الطائفة، وبذلك ينغمس المجتمع في جو من الريب والتحاقد، وتأليف الرؤى المظلمة عن الآخر الذي سيصبح تلقائيًا الغريب والمريب والمتخفي والغامض والمرتبط.
إنني أؤكد أن الحل الذي يعتمد طمس الهويات جاء بنتائج عكسية تمامًا، في حين أننا نستطيع اعتماد المذهب أو الطائفة أو القومية رافعًا وطنيًا، من خلال احترام الآباء المؤسسين وتكريمهم وتوفير بيئة صحيحة لهم في البناء السوري.
إن سورية مؤلفة من قوميات عدة، وعلى الدستور أن ينص عليها صراحة وباحترام، وهي كذلك تستخدم لغات عدة، وعلى الدستور أن يشير إليها باحترام، وأديان وطوائف عدة، وعلى الدستور أن ينص عليها باحترام يمنع كل سعي أسود في الظلام لتشويه هذه الهويات وشيطنتها.
إن وجود رموز مدمرة للوحدة السورية في الطوائف أمر وارد، ومن المنطقي وضع معايير لاحترام الرموز الطائفية والمذهبية والدينية، والتركيز على أصحاب الاتجاه الإنساني في كل ملّة ومذهب وقومية، وهم في الواقع يشكلون الأغلبية الساحقة من كل هوية، فالإنسانية تقدس تلقائيًا الزعماء الإنسانيين، وترفض تلقائيًا الزعماء المتوحشين مهما كانت قوتهم وسلطتهم، وليس عسيرًا أن يتم إحياء القيم النبيلة التي تحظى بإجماع كبير، وطرحها روائز للوحدة والوطنية والمحبة في كل برامج الوطن الجديد بدلًا من طمسها وتغييبها.
العلمانية
إن الخيار العلماني يقدم لنا نموذجين واضحين: الفرنسي والبريطاني، ومن دون تردد أرى أن النموذج البريطاني هو الأقرب إلى ثقافة شعبنا ومستوى تمسكه بالدين والطائفة والمذهب، وليس النمط الفرنسي اللائكي الذي صنّف نفسه تلقائيًا من حيث لا يريد معاديًا للقيم الدينية.
إن القسم الملكي الذي سمعناه بلسان الملك تشارلز، وكذلك قسم ليزا تراس أمام الملكة، يطفح بذكر هويات طائفية ودينية أساسية في بريطانيا، ويتعامل معها ليس بمستوى الاحترام فحسب بل بمستوى القداسة أيضًا.
وأعتقد ان النص على علمانية الدولة ليس مفيدًا، في الراهن الحالي على الأقل، في ظل وجود سببين أساسيين:
الأول: وجود ثورة عارمة ضد نظامٍ ادعى أنه يطبق العلمانية ستين عامًا، وأورث سورية هذا الواقع الكارثي، وقد ارتبط ذلك بشكل عنيف بخطاب الثورة والثورة المضادة وبات المصطلح غير حيادي على الإطلاق، ولم تعد تجدي الشروح الأكاديمية والتعريفات الأنيقة لانتزاع المصطلح من بؤرة التطاحن المجتمعي.
الثانية: تحول كثير من العلمانيين إلى التفكير بروح الطائفة العلمانية، بحيث يتم تلقائيًا زج التيارات الرافضة للعلمانية في دائرة التخوين والارتباط والارتهان، وهذه الطائفة أسهمت بشكل كبير أيضًا في إفقاد هذا المصطلح حياديته ومعناه الإيجابي.
واقترح بدلًا من ذلك مصطلح دولة القانون والمساواة.
التربية والتعليم
وجوب النص على حق كل مواطن في أن يتلقى التعليم العام، بشكل يضمن المساواة والتكافؤ مع المواطنين جميعهم، وواجب الدولة والمجتمع تأمين هذا التعليم قبل بلوغه السن القانوني، ومن ثم رفض تسرب الطلبة من التعليم العام إلى أي تعليم آخر، قبل اكتمال سن الرشد وقدرة الطالب على الاختيار.
الجيش
أما الجانب الأهم الذي أهملته الوثيقة فهو الجيش، مع أنه يقع في جوهر التوافقات الوطنية المطلوبة.
يتعين النص بوضوح على مسؤولية الدولة في تأسيس جيش احترافي وطني، يقوم بدوره المهني في حماية البلاد وصيانة حدودها، ويمتنع على أفراده وضباطه الانتماء إلى أي تنظيم سياسي، وبناء الجيش على أساس من الوطنية الخالصة، ومنع الترويج لأي معتقدات دينية أو حزبية أو سياسية فيه، واعتبار رفع صور الأشخاص والأحزاب انتهاكًا صارخًا لحيادية الجيش.
ويتعين النص بوضوح على أن الجيش المأمول هو جيش احترافي قائم على الراغبين في العمل العسكري والتفرغ له، وفق أرقى المدارس العسكرية الناجحة في العالم، بعيدًا عن جيوش النظم الشمولية والعقائدية.
ويتعين الوقف الفوري للتجنيد الإجباري الذي كان أكبر سبب لنزيف الخبرات المستمر في سورية منذ ستين عامًا، ما أدى إلى فقر واضح بالكفاءات والمواهب، إضافة إلى إفراز حالة القهر والعذاب التي شهدها الجيش السوري إبان الأحداث التي وضعت العسكري في أقسى خيار ممكن على الإطلاق، بإرغامه على حروب ضد أهله ومجتمعه، ودفعه إلى الفرار أو الانشقاق، الأمر الذي تسبب في إزهاق حياة عشرات الآلاف من أبناء الوطن العسكريين بأيدي السوريين أنفسهم.
إن قيام نظام خدمة وطنية مواز لمدة عام واحد ينخرط فيه المواطنون جميعًا من دون استثناء أمر إيجابي وممكن، بشرط أن يكون مدنيًا بالكامل، وأن ينص بصراحة على أنه لا يجبر الناس على حمل أي سلاح.
—————————–
ندوة حوارية لمناقشة “مشروع وثيقة توافقات وطنية”
تتشرف اللجنة التنفيذية لمشروع التعاون المشترك بين المنصّات الحوارية: مركز حرمون للدراسات المعاصرة/ برنامج الحوار الوطني، ومنتدى الحوار المدني الديمقراطي/ مدى، والجمعية السورية للباحثين في العلوم الاجتماعية، ومنظمة مسار للديمقراطية والحداثة، ومنتدى المستقبل، والمنتدى الدستوري، بدعوتكم يوم الجمعة 26 أيار/ مايو 2023، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دمشق، الثامنة بتوقيت وسط أوروبا، للمشاركة في الندوة الحوارية المخصصة لمناقشة “مشروع وثيقة توافقات وطنية”، الذي أصدره مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
يشارك في الندوة كلٌّ من: سمير سعيفان، مدير مركز حرمون للدراسات؛ وعبد الله تركماني، باحث في مركز حرمون؛ وبدر الدين عرودكي، كاتب ومترجم؛ ونادر جبلي، باحث في مركز حرمون؛ ويُديرها خضر زكريا، رئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية.
محاور الندوة:
– فكرة عن مشروع الوثيقة: الأسباب والدوافع والقيمة المضافة.
– أهمية المشروع والحاجة إليه.
– قدرة المشروع على إنتاج مبادرات ملموسة.
– العقبات أمام المشروع وطرق تذليلها.
سيجري اللقاء عبر تطبيق (زوم)، وستُبث الندوة على معرّفات مركز حرمون على الروابط التالية:
-فيسبوك: https://www.facebook.com/HarmoonCenter
-تويتر: https://twitter.com/HarmoonCenter
-يوتيوب https://www.youtube.com/@HarmoonOrg/streams
يمكن الاطلاع على “مشروع وثيقة توافقات وطنية” على الرابط: https://bit.ly/45aauTi
———————-
(مشروع وثيقة توافقات وطنية سورية) مقاربة واقتراحات/ حمزة رستناوي
دور النصوص والوثائق في العمل السياسي
بداية، لا تنبغي المبالغة في أهمية الوثائق الفكرية السياسية في عملية التغيير السياسي، وتحميلها ما لا تحتمل؛ فهي جهود فكرية-ثقافية، تحاول أن تحظى بصفة المرجعية السياسية التوافقية. وهذه الصفة الاعتبارية المُحِّقة لا تتعلق بمضمون الوثيقة فحسب، بل بسياقات ظهورها وتسويقها ومحاولات إدماجها في صيرورة التغيير السياسي المأمول. وإن مصدر الوثيقة في هذه الحالات أمرٌ مُهمّ، فكلما كان المشاركون والموقّعون على هذه الوثيقة يتمتعون بنفوذ سياسي وشعبية جماهيرية أكبر؛ كان تأثير هذه الوثيقة أكبر. ولنتوقف عند (مشروع توافقات وطنية)، حيث إن هذه الوثيقة تعبّر عن مُخرجات برنامج الحوار الوطني الذي جرى على مدى 13 شهرًا، وشارك فيه 187 شخصية سورية مُختصة، من مختلف الانتماءات والثقافات، ومن ثم عُرضَت على شريحة أوسع من المثقفين السوريين والمهتمين بالشأن العام (ص8). وينبغي التنبيه إلى أن المشاركة في النقاشات لا تعني المُوافقة على كلّ ما جاء في هذه الوثيقة، وقد قام مركز حرمون للدراسات المعاصرة بدور المُنسّق، واكتفى بدور الإدارة لهذا الجهد البحثي، ولا تعبّر هذه الوثيقة بالضرورة عن وجهة نظر مركز حرمون، ولا عن رؤية الجهات المُموّلة له. وهذه النقطة مهمّة لتجنّب الدخول في نقاشات واتهامات وشَخصَنات غير مثمرة، لا تخدم المشروع الوطني السوري المأمول من هذا الجهد الفكري-السياسي.
ومن الواضح أن غالب المشاركين والمهتمين بإدارة نقاشات حول هذه الوثيقة هم فئة (نخبوية) من المثقفين السوريين غير المُنظّمين أو غير المُشتغلين بالسياسة بالخاصة، وهم ليسوا من الفاعلين الاجتماعيين، بالمعنى الشعبي المؤثر في اتجاهات الرأي العام السوري. ومع الأسف، ما يزال الفضاء العام السوري مُهيمنًا عليه، ثقافيًّا، من قبل الخِطابات الشعبويّة الدينية والطائفية والقومية والارتهانات الانتهازية والفئوية الضيقة. وهذه الوثيقة هي محاولة للفعل في زمن القنوط، ومحاولة للتفكير بالمشكلة السورية، ومحاولة إيجاد توافقات بالاستفادة من مُنتجات علم الفلسفة السياسية والاجتماع السياسي الحديث. وإن عملية التلقّي لوثيقة التوافقات مهمّة، وغالبًا ما سوف تصطدم بنمط الاستقطاب السائد سوريًّا، الذي يُشيطن المُختلف، ويجتهد في سبيل تقزيم أي محاولة للتغيير، ويكتفي بتناول الأشخاص والنيّات والدوران في فلك نظرية المؤامرة، وأخطر ما يواجه هذا النمطَ من الجهود الفكرية الرصينة هو الإهمال وعدم التفات الفاعليين والقوى السياسية إليه، لتعارض مصالحهم مع طروحات حيوية وطنية كهذه.
هذه الوثيقة ليست المحاولة الأولى لعمل وثيقة توافقية فكرية سياسية للسوريين، فقد سبقتها كثير من المحاولات، من قبيل وثيقة العهد الوطني بالقاهرة 2012، التي جرت تحت إشراف الجامعة العربية في زمن وسياق مختلفين، ولن تكون هذه الوثيقة هي الأخيرة. ومن المُهمّ تسويق هذه الوثيقة وتعزيز النقاشات حولها، بغية تطويرها من جهة النوعية، وتعميمها شعبيًّا، والتحاور حولها وملائمتها وتعديلها، وهنا تلعب وسائل الإعلام الدور الأكبر في ذلك. والسؤال المطروح: هل يوجد حامل اجتماعي سياسي لهذا النوع من الوثائق؟ في الحقيقة، في ظلّ شبه غياب لحياة سياسية تمثلّها أحزاب وتيارات فاعلة، من الصعب الحديث عن حامل. وفي ظل غياب شخصيات سياسية سورية فاعلة ومؤثرة (باستثناء السلطة الأسدية وسلطات الأمر الواقع الأخرى)، من الصعب الحديث عن حامل. وفي ظلّ هيمنة سلطات مُستبدة قامعة للحرية لا تسمح بحرية الرأي والتعبير ضمن الجغرافيا السورية، من الصعب إدارة حوار مُثمر حول هذه الوثيقة وغيرها، يفضي إلى تبنيها من قبل قوى وشخصيات سياسية فاعلة. وفي ظل عدم الاهتمام الدولي والإقليمي بإسقاط الأسديّة والتغيير السياسي في سورية، من الصعب ترجمة وثيقة توافقات إلى نصوص ذات طبيعة دستورية أو سورية جامعة، ولو مرحليّا.
إنّ سؤال الحامل الاجتماعي-السياسي هنا مهمّ ومشروع، وربّما يُفضي إلى اليأس، ولكن إلى أي درجة؟ في هذا السياق، سوف أعرض لنقطتين: الأولى ثمة جهدٌ ينبغي القيام به بغض النظر عن ضمان النتائج، لكونه جهدًا مطلوبًا وسوف نحتاجه نحن السوريين في مرحلةٍ ما في المستقبل، بحيث تكون وثيقة التوافقات وما يشابهها من الجهود الفكرية-السياسية مُتاحةً للاطلاع عليها والاستفادة منها، من قبل صانعي القرار في لحظة معينة. والثانية تُقدِّم الوثيقة -من وجهة نظري- مقاربة رصينة ومُتفهّمة لعدد من القضايا الإشكالية في الحياة السياسية السورية، من قبيل العلمانية والمبادئ فوق الدستورية والعدالة الانتقالية وغيرها، وهذا بحد ذاته خطوة مهمّة لتخفيف الاستقطاب العاطفي، وإعادة السوريين إلى حقل التفكير السياسي العام. في الفقرات التالية من هذه المقاربة، سوف أتناول بعض القضايا الإشكالية التي طرحتها (وثيقة التوافقات) في المحاور التالية: المبادئ فوق الدستورية؛ العلمانية؛ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية؛ هوية الشعب السوري وإشكالية الإشارة إلى مصادر التشريع.
أولًا: المبادئ فوق الدستورية
تطرح الوثيقة فكرة (القواعد الدستورية المحصّنة- ص11)، أو ما يُعرف عالميًّا بالمبادئ فوق الدستورية، وتوصِّف الوثيقة هذه المبادئ بكونها (قواعد دستورية ذات أهمية خاصة في دولة بعينها، تُعطى حصانة استثنائية ضد التعديل والتغيير تفوق الحصانة التي تُعطى لباقي قواعد الدستور، بحيث يكون تعديلها أو تغيرها أو إيقافها …أمرًا بالغ الصعوبة على السلطات)، كما تبرر الوثيقة ضرورتها في الحالة السورية (ضمان الحقوق والحريات، تحصّن النظام السياسي من تسلل الاستبداد، خلق مناخ من الثقة بين السوريين.. حيث إنها تعالج الخلافات السياسية الكبرى بين الجماعات السورية، وتعالج مخاوفها وهواجسها المُختلفة). وتؤكد الوثيقة ضرورة عدم التوسّع في القواعد الدستورية المُحصّنة إلا بالمقدار اللازم والكافي لتحقيق الغرض. وتعقيبًا على موضوع المبادئ فوق الدستورية التي تطرحه الوثيقة، يمكن القول بوجاهة هذه المبادئ، وسوف أعرض للنقاط التالية ذات الصلة:
يوجد مبادئ عامة للإدارة السياسة والحكم الرشيد -عابرة للعصور والمجتمعات- وسورية ليست استثناء في تاريخ الدول. تستند هذه المبادئ إلى مشروعية حقوق الإنسان نفسِها، فكل سوري هو مشمول في جنس الإنسان، وليس العكس، والمُواطنة السورية يجب أن تستند إلى شرعية حقوق الإنسان وليس العكس. بالطبع، يوجد خصوصية معينة للسوريين، وبالطبع يوجد خصوصيات مُختلفة للفئويات السورية نفسها، ولكنها مُجرّد تعينات ظرفية للكينونة الاجتماعية -سواء أكانت فردًا أو جماعة- ولا تخرق المبدأ العام. إن مشروعية المبادئ فوق الدستورية إلى حدّ كبير هي مشروعية بدهيّة فطرية، التزامًا بأولويات الحياة والعدل والحرية، وهي أولويات يعيشها ويقبلها ويطلبها الناس عبر العصور والمجتمعات، ومن ضمنهم السوريون.
للمُوازنة ما بين العام والخاص، يمكن التمييز بين مجموعتين من المبادئ فوق الدستورية. مجموعة المبادئ العامة التي تستند إلى شرعية حقوق الإنسان، ومثالها مبدأ المواطنة المتساوية أو حق السوري في التعليم الأساسي المجّاني. مجموعة المبادئ الخاصة التيتستند إلى التعين السوري في السياق السياسي الحاضر، ومثالها وحدة التراب السوري ضمن الحدود المُعترف بها دوليًّا، أو اقتراح: سورية دولة فيدرالية-اتحادية، أو اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية مثلًا، أو اقتراح تقييد مدة ولاية رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين فقط.
إنّ مشروعية المبادئ فوق الدستورية،سواء أكانت مُنفصلة أو مُتضمَّنة في الدستور،تأتي مناستقراء التجارب السياسية للدول الناجحة عبر العالم؛ حيث تتضمن كثيرًا من المبادئ فوق الدستورية. وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأميركية التي تم إقرارها في 1791، تبدأ بجملة (لا يحق لمجلس الشيوخ سنّ قوانين تفرض اتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثًا أو كتابة أو تحدُّ من حرية الصحافة، ولا يحق لمجلس الشيوخ كذا وكذا..) إلخ. الحقوق الأساسية في الدستور الألماني الاتحادي التي تشكل المواد من 1-19 تم تذييلها بجملة (لا يمكن حذف هذه الحقوق الأساسية من الدستور، ولا يجوز لأي تعديل دستوري أن يمسّ جوهرها).
في البلدان غير المُستقرة سياسيًّا، والبلدان عالية الخطورة لحدوث انتهاكات حقوق الإنسان مُمثلة بالدكتاتورية والانقسام الفئوي الهوياتي وهيمنة تيارات شعبوية… إلخ، تكتسب المبادئ فوق الدستورية أهميّة إضافية، لتحصين المواطن من إساءة استعمال السلطة من قبل العسكر، وحمايته من دكتاتورية الأغلبية.
يحتجُّ البعضُ بكون المبادئ فوق الدستورية قد لا تحظى بتوافق غالبية السوريين عليها، وقد يصوِّتون ضدها مُستقبلًا، فكيف لنا أن نُلزِمُهم ونُلزم الأجيال القادمة بذلك؟ قد يبدو هذا الاعتراض وجيهًا للوهلة الأولى، وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:
المبادئ فوق الدستورية لا تأخذ الطابع التفصيلي عادة.
الدستور والمبادئ فوق الدستورية تدخل في مجال مرجعية الاختصاص السياسي-القانوني، وليست بالضرورة مرجعية عامة الناس أو عامة السوريين، ولكنها بالطبع لا تأخذ صفة الشرعية قبل عرضها وقبولها من غالب السوريين.. وهذه الفجوة يمكن مَلؤها بالنقاشات العامة والتسويق المُناسب والتعديلات وتدقيق الصياغات.
يمكن لبعض السوريين أو حتى أكثرية عددية منهم (في لحظة معينة) تبرير الظلم تجاه شخص أو فئوية سورية مُعينة، ولكنّ هذا لا يُشرعِن الظلم، بل يُنظر إليه كقصور مُمِكن ومُؤقت يعتري الكينونة الاجتماعية، ينبغي فهم أسبابه وتصحيحه. سأعرض أمثلة لتوضيح هذه الفكرة: افتراضًا، في لحظة سُعار قومجي أو كردّة فعل تجاه حدث سياسي عنيف مثلًا، يمكن لغالب السوريين أن يصوّتوا لصالح قانون يسمح بتجريد المُواطنين الكرد أو غيرهم من حق الجنسية السورية! كذلك يُمكن توقُّع أن يصوّتَ غالب السوريين على قانون يسمح بالتعذيب، بحجّة الحفاظ على الأمن الوطني في ظرف معيّن مثلًا! في هذه السياقات تحديدًا، تأتي أهمّية المبادئ فوق الدستورية، بكونها تتسامى على قرارات اللحظة الاجتماعية-السياسية، وما قد يعتري البشر من قصور مُمكن ومُتوقع.
إنّ التخلي عن مُقترح المبادئ فوق الدستورية سوف يجعل الدستور السوري المأمول أضعف وأكثرَ قابلية للتعديل والتلاعب غير البريء، من قبل النافذين.
النصوص القانونية ذات الطبيعة الفئويّة المؤدلجة، سواء أكانت دينية أو قومية أو مناطقية، لا تصلح لأن تكون بديلًا عن المبادئ فوق الدستورية، حتّى لو كانت موضع قبول غالبية السوريين. لكونها تخرقُ مبدأ المواطنة المتساوية والوطنية السورية الجامعة.
ثانيًا: العَلمانية
تُعرّف الوثيقة العَلمانية (فصل السلطة السياسية ومؤسسات الدولة عن الدين والمؤسسة الدينية. فلا يتدخل مُمثلو الدين بشؤون السياسة والحكم، ولا تتدخل السلطة السياسية ومؤسسات الدولة بشؤون الدين، بل تبقى حيادية تجاه الأديان والمعتقدات، مع التزامها بحمايتها جميعًا وتوفير الشروط اللازمة ليمارس أتباعها طقوسهم وشعائرهم وعباداتهم بحرية وأمان – هامش ص20)، وتطرح الوثيقة مفهوم العَلمانية، كإجراء مفيد لتنظيم الحياة السياسية، وكجزء من منظومة فكرية سياسية تتضمن المُواطنة المتساوية والديمقراطية (تقتضي العَلمانية تلازم مفهوم العلمانية وتكامله مع مفهومي المُواطنة والديمقراطية- ص9)، وتضيف الوثيقة شروحات إضافية لتحديد فهمها للعلمانية: (تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع السوريين، مع حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات – ص9). وفي مبررات حضور العلمانية سوريًّا تضيف الوثيقة: (العلمانية خيار ضروري لإنقاذ سورية مما هي فيه، ولبقائها موحدة، ولتوفير شروط استقرارها ونهوضها، بسبب حالة التعدد الاثني والديني التي تشكِّل النسيج السوري، وبسبب الرضوض الشديدة التي أصابت العلاقات بين الجماعات السورية جراء حقبة الاستبداد. يجدر بالسوريين اجتراح علمانية لينة خاصة بهم، يمكنها التلاؤم مع بيئتهم وثقافتهم انطلاقًا من فهم معوقات العلمانية في مجتمع يلعب فيه الدين دورًا مُهمًّا وتعاني فيه العلمانية من سوء الفهم والسمعة والمواقف السلبية المسبقة –ص9). وفي موضع آخر في الفقرة الخاصة بمعالجة الأزمة الطائفية، تضيف الوثيقة: (خطاب علماني ذكي وجديد ومختلف متفهم للثقافة والبيئة، يركز على المضمون ويبتعد عن استفزاز المتدينين– ص16)، كما تؤكد الوثيقة على (أن تكون المنظومة القانونية في سورية الجديدة حيادية تجاه الأديان والمذاهب، تجرم الطائفية، وتمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني مذهبي- ص9).
وتعقيبًا على موضوع العَلمانية الذي تطرحه الوثيقة، سوف أعرض للنقاط التالية ذات الصلة:
إنّ وثيقة التوافقات الوطنية أو الخطابات المُشابهة لها تُقدِّم فهمًا مُحدّدًا للعلمانية، يتَّسم بالوضوح ويؤكد ضرورتها، ويتّسم بالتفهّم لضرورة تقديم علمانية ليّنة -غير مُعادية للدين- تناسب خصوصيات المجتمعات السورية المُتدينة في العموم.
أي نقد لمفهوم العلمانية في الوثيقة، خارج ما قامت الوثيقة نفسها بشرحه وضبطه، يعبّر عن خطاب غير مُنصف وشعبوي مُضلل، ومنه مثلًا القول بأن العَلمانية التي تدعو لها الوثيقة هي نفسها العلمانية التي يسوِّق لها النظام الأسدي! ومنها كذلك القول بأن العلمانية التي تدعو لها الوثيقة تدعو للانسلاخ من الدين والثقافة والإرث الحضاري الإسلامي!
إنّ مُصطلح (تجريم الطائفية) الذي تعرضه الوثيقة هو عام وغير مُخصص، وتم استهلاكه كثيرًا إعلاميًّا، ومن هنا، أقترح مصطلح تجريم العنصرية بكل أشكالها، بما يشمل التمييز على أساس الانتماء العقائدي والديني بين السوريين.
العديد من الأحزاب السياسية في الدول ذات التجارب الديمقراطية المُتقدمة هي ذات بعد أو خلفية دينية، ومنها الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا وحزب العدالة والتنمية في تركيا وغيرها، من هنا ينبغي توضيح المقصود بـ (منع تشكيل الأحزاب على أساس ديني مذهبي)، وهنا أقترح أن يكون معيار قانون تشكيل الأحزاب هو أن لا تتعارض مبادئ الحزب مع مبدأ السيادة للشعب ومبدأ المواطنة المتساوية وباقي النصوص الدستورية الحاكمة. إنّ هذا يقتضي تقديم فهم حيوي وطني للدين يؤكد على أولويات الحياة والعدل والحرية. والمبدأ نفسه ينطبق على تشكيل الأحزاب على أساس قومي، حيث ينبغي اشتراط قبول الحزب بالمبادئ الدستورية الناظمة للمساواة بين السوريين، وقبول مبدأ (سورية دولة مُوحدة كاملة السيادة، لا يجوز التنازل عن أي جزء من أجزائها- ص7). إن وجود أحزاب ذات بعد قومي مناطقي شائع في معظم التجارب الديمقراطية الحديثة، كما في حزب الكتلة الكيبيكية في كندا، وحزب رابطة الشمال في إيطاليا، وحزب الحزب الوطني الاسكتلندي في بريطانيا.
ثالثًا: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية
تؤكد وثيقة التوافقات على (تبنّي الدولة السورية القادمة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوثائقها الثلاثة، وتعمل على تكريسها قانونيًّا ودستوريًّا، باعتبارها خلاصة وذروة ما أنتجته الحضارة البشرية في مجال حقوق الإنسان.. وقد أصبحت المصدر الرئيس للدساتير حول العالم- ص13)، بالمقابل تدرك الوثيقة مشكلة وجود تعارض بعض تلك الحقوق مع ثقافة المجتمع وقيمه السائدة، وتدعو لاجتراح الحلول المناسبة لها، أسوة بدول أخرى ذات أغلبيات مسلمة وذات مستوى حضاري متقارب- ص13، وتطرح الوثيقة إمكانية وجود قانون مدني عام ينظّم الأحوال الشخصية للسوريين، إلى جانب تلك القوانين الخاصة بالطوائف والمذاهب، وأن يُترك للناس حرية اللجوء إليه، إن رغبوا في ذلك- ص13.
الموضوع الذي تطرحه الوثيقة هو إشكالي بالنسبة إلى السوريين، وقد جاء طرح الوثيقة مُتفهِّمًا لصعوبات تبني هذا الطرح، واقترحت مبدأ الاختيار ومبدأ ملائمة التشريعات بما يناسب خصوصية المجتمعات السورية. قد يكون تبني الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكون جزءًا أصيلًا من أي وثيقة دستورية قادمة، هو حالة مطلوبة، ولكن الإشكالية هنا في كيفية الانتقال من المثالي إلى الواقعي، ومن المطلق إلى النسبي، ومن المعرفي إلى السياسي-الاجتماعي. لنتساءل: هل تضمين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بنصّ صريح في الدستور سيسهل عملية قبوله والتصويت عليه من قبل غالب السوريين لاحقًا، أم سيعرقلها؟! أنا هنا أتساءل فقط.
المادة 16- 1 من الإعلان العالمي: للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
المادة 18 من الإعلان العالمي: لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو مُعتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
هذان النصّان يتعارضان مع ما يُسمَّى اصطلاحًا (بأحكام الشريعة الإسلامية) التي دُشّنت، بصيغتها السائدة اليوم، في القرون الوسطى في العصر العباسي، بما يناسب الشرط التاريخي والسياسي والمعرفي آنذاك. وما تزال أحكام هذه الشريعة تحظى بالقبول عند شرائح واسعة من السوريين (المسلمين السنة). لا ينبغي اختزال الدين بأحكام الشريعة الدينية؛ فالإيمان الإسلامي لا يساوي الشريعة الإسلامية، فأحكام الشريعة أو المنظومة القانونية مُتغيرة بتغير العصور والمصالح والفهوم. وإنّ أي فهم حيوي ينبغي أن يؤكد على ثوابت التوحيد والعدالة وحسن التعامل ومكارم الأخلاق.
بناءً على نصّ هاتين المادتين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ يجوز للمرأة المُسلمة الزواج من رجل مسيحي مثلًا، ويحق للمرأة تزويج وتطليق نفسها، وإلغاء شرط المهر باعتباره شرطًا غير متساوٍ بين الزوج والزوجة. وبناء على هاتين المادتين، يحق للمسلم ترك الإسلام واعتناق أي دين آخر والتصريح بذلك للملأ، كذلك يحق لأي سوري الدعوة إلى دين جديد، مثلًا، ونقض الإيمان الإسلامي وغير الإسلامي كذلك، كما هو موجود وحاضر في دول ذات نظم ديمقراطية-علمانية كثيرة حول العالم.
ولا يوجد في القرآن الكريم نصٌّ واضحٌ يقول بقتل المُرتدّ أو بأي عقوبة دنيوية لتارك الإسلام، بل إن العكس هو الصحيح، ولننظر في الآيات القرآنية التالية التي تؤكد حرية الاعتقاد، سواء أكان إيمانًا أو كفرًا: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } [البقرة256]؛ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} [يونس 108]؛ {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ} [الكهف 29]؛ {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس99].
إن هذه المعارضة لن تكون فقط من قبل رجال الدين المسلمين السنّة أو الشيعة؛ فالطوائف المسيحية مُمثلة برجال الدين فيها، وكذلك الموحدون الدروز وغيرهم، لن يكونوا أقلّ حماسًا في رفض هاتين المادّتين، وخاصة المادة الأولى التي تشرعِن زواج المرأة من خارج الفئوية الدينية.
ولا ينبغي شرعنة وقبول المصالح الانغلاقية التي يعرضها مُمثلِّو الشّخصنَات الدينية على اختلافها، ولكن ينبغي التنبّه إلى المصاعب التي قد تواجه إقرار هذا النمط من الوثائق الدستورية مستقبلًا. ومن هنا، أقترح إجراء تعديلات على صياغة هاتين المادتين، في حال تضمينهما في أي وثيقة دستورية مأمولة، وإنشاء صيغة تسعى لتدوير الزوايا الحادة بما يجعلها أكثر قبولًا، على ألا تُعطي ذريعة للشخصنات الفئوية الدينية بما يبرر انتهاك حقوق الإنسان.
وما دمنا نتكلم عن وثيقة دستورية، فالمطلوب هو إقرار مبادى عامة، وليس أحكامًا تفصيلية، فهذا يقع خارج إطار الوثيقة الدستورية، وهو متروك لاجتهادات رجال القانون والنخب الاجتماعية-السياسية ذات المصلحة. ويمكن اقتراح الصيغتين التاليتين المُعدّلتين للمادة 16-1 والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 16- 1، للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
إعادة صياغة المادة 16 –1، للرجل والمرأة حقوق ووجبات متساوية، وللسوريين والسوريات الحق في الزواج وتشكيل الأسرة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى (موروثة أو مكتسبة)، سواء أكانت ثقافية أو اجتماعية أو مناطقية أو غير ذلك.
المادة 18، لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
إعادة صياغة المادة18، يضمن الدستور حرية الاعتقاد الديني (لا إكراه في الدين) للسوريين، ويضمن حرية التفكير والتعبير عن الاعتقادات والآراء والتوجهات السياسية وغير السياسية، بما لا يتعارض مع أولويات الحياة والعدل والحرية.
الصياغة المُعدّلة هنا جاءت عامّة وأقلّ تفصيلًا، وتتجنب الإشارة الصريحة للنقاط الإشكالية، ولكنّها بالمقابل لا تجامل أو تُعطي أي ذريعة لتقييد الحرية الدينية وحرية الاعتقاد.
لنتوقف عند المادة 16- 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المُزمع زواجهما رضاءً كاملًا لا إكراهَ فيه). وتعقيبًا على ذلك، نتطرق إلى بضع نقاط:
لا يوجد أي نص قرآني أو حديث نبوي (صحيح) يُشرعن أو يسوغ إكراه المرأة على الزواج، وغالب المُمارسات المُجحفة تتعلق بالعادات والتقاليد وهيمنة الثقافة الذكورية اجتماعيًا.
كثير من الفقهاء المسلمين، خاصة في المذهب الحنفي، يُجوّزون أن تكون العصمة بيد المرأة، بناءً على اشتراط عقد الزواج أو التفويض، وأن يكون لها الحرية في تطليق نفسها. يوجد العديد من الاجتهادات الفقهية الحديثة -وفقًا للباحث الإسلامي أحمد الرمح- تجوّز ذلك، وكذلك فتوى حسن الترابي مثلًا التي لا تمانع في زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي (مسيحيًّا كان أو يهوديًّا)، وفي كل الأحوال، إنّ الالتزام بالنصوص والفتاوى الدينية الخاصة بالجماعة الفئوية هو حق وخيار للشخص نفسه، ولا ينبغي أن يتحوّل إلى قانون عام.
· لا نجد تعارضًا بين المادتين (المادة 16- المادة18) والنصوص القرآنية ذات الصلة في هذا المجال. مع التذكير بكون اللا- تعارض الصريح لا يساوي التوافق الصريح.
التعارض هو فقط مع الصياغات الفقهية المُدشنة منذ العصر العباسي التي تتضمن بعض الأحاديث المنسوبة للنبي محمد.
إنّ تبني الوثيقة الدستورية المأمولة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد يكون ضروريًّا، كونه يعطي الدولة السورية سمتها كدولة مواطنة متساوية، وبما يسهم لاحقًا في تعزيز الهوية الوطنية السورية، مقابل الهويات الفئوية العمودية.
رابعًا: هوية الشعب السوري وإشكالية الإشارة إلى مصادر التشريع
جاء في وثيقة التوافقات: (يعتزّ الشعب السوري بتراثه الحضاري، على تنوّعه، وبانتمائه إلى الحضارتين العربية والإسلامية، ويسعى لتوطيد علاقات صداقة وتعاون وثيقة ومستقرة ومتوازنة مع الدول العربية – ص 7)، وجاء في موضع آخر: (يجب أن لا يتضمن الدستور والقانون أي نصوص تشير إلى التمايز بين الجماعات السورية، ويجب أن تكون التشريعات وضعية. الدولة السورية الجديدة يجب أن تكون منزوعة الصفات، لأنها فضاء مُشترك لا يجوز احتكاره من قبل أي جماعة مهما كانت كبيرة، لأن في ذلك إقصاءً لجماعات أخرى- ص20). وتعقيبًا على ذلك، سأعرض للنقاط التالية:
لنميّز ما بين الحقل السياسي-القانوني، والحقل الثقافي-الحضاري. ضمن الحقل السياسي-القانوني، ينبغي أن تكون الدولة منزوعة الصفات الأخرى، باستثناء كونها دولة سورية، أي دولة لجميع السوريين دونما تمييز. بينما في الحقل الثقافي-الحضاري، الشعب السوري هو شعب متعدد الثقافات والهويات الدينية والقومية والمناطقية، كغيره من شعوب الأرض. يشكل البعد العربي-الإسلامي بُعدًا مُهمًّا في انتماء السوريين الثقافي والحضاري، إضافة إلى أبعاد أخرى، ولا سبيل إلى إنكار هذا البُعد الملموس، سواء تضمّنت الوثائق الدستورية أو السياسية ذلك، أم لا. كما ينبغي التأكيد على المقصود بالعروبة، فهي أوسع من كونها قومية وعرقًا، كما ينبغي النظر إلى الإسلام نظرة أوسع من كونه عقيدة دينية فقط يحتكرها المؤمنون.
يمكن اقتراح تضمين وثائق دستورية سورية مستقبلية صيغًا، من قبيل (الشعب السوري ينتمي ثقافيًّا إلى الفضاء العربي الإسلامي وفضاءات مَشرقية ومتوسطية متنوعة وغنية، دون أن ينبني على التعدد والغنى الثقافي أي امتيازات سياسية وقانونية، سواء أكانت سلبية أو إيجابية).
أقترح عدم إدخالمواد أو إشارات تعطي الدولة طابعًا دينيًا فئويًا، وبما قد يسهِّل لاحقًااستغلالمواد وإشارات من قبيل:دين رئيس الدولة، أحكام الشريعة الإسلامية، القرآن، السنّة النبوية، ونحوها.
تطبيق صيغ وسطية اختيارية، في قضايا إشكالية وحسّاسة، من قبيل حرية اختيار الزوجين لنمط عقد الزواج، ديني أو مدني؟ وكذلك حرية اختيار الورثة لنمط توزيع الإرث.. إلخ.
دساتير البلدان العربية كافة تتضمن فقرات، من قبيل (الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، الدولة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنّة النبوية هما المصدر الأساسي للتشريع.. إلخ). في الحقيقة، إن تضمين أي وثيقة دستورية سورية إشارات إلى الشريعة الإسلامية سوف ينبني عليه تمايزات في التعامل بين المواطنين السوريين، حيث إنّ (أحكام الشريعة الإسلامية) ذات مرجعية فئوية، وهي عمل اجتهادي بشري، بالاستناد إلى فهوم وتفسيرات مُعينة للنصوص المقدسة صيغت في عصور ما قبل نشوء الدولة الحديثة ومبدأ العقد الاجتماعي والمواطنة المتساوية.
يمكن اقتراح تضمين الصيغة التالية: مقاصد الشريعة الإسلامية (بمقتضى أولويات الحياة والعدل والمساواة والحرية بين البشر والسوريين) هي أحد مصادر التشريع السوري. مع ملاحظة أنّ مقاصد الشريعة -كما اصطلح عليها عموم الفقهاء المسلمين- لا تتوافق مع أولويات الحياة والعدل والحرية التي هي أولويات يقبلُها عموم الناس عبر العصور. كيف ذلك؟! يبدو ذلك في إعطاء علماء أصول الفقه المسلمين الأولوية لحفظ الدين على حفظ النفس وبقية المقاصد.
من هنا، قد يكون عدم الإشارة إلى فقرة مصادر التشريع خيارًا واردًا، أو الاكتفاء بكون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي مصدر أساسي للتشريع، أو استخدام صيغة (مقاصد الشريعة الإسلامية، بمقتضى أولويات الحياة والعدل والمساواة والحرية، هي أحد مصادر التشريع السوري. من ميزات الخيار الأخير أنه يسهم في تسويق الوثيقة الدستورية شعبيًّا، ويعزز الشعور النفسي الإيجابي بالانتماء الحضاري للسوريين، ويؤكد الجانب الحيوي (العابر للمجتمعات) من الإرث الثقافي الإسلامي، من غير أن ينبني على ذلك أي قوانين تميزية بين السوريين.
إن مقاصد الشريعة الإسلامية بمقتضى أولويات الحياة والعدل والحرية هي نفسها مقاصد أي شريعة (بغض النظر عن اسمها ومصدرها)، تلتزم بتلك الأولويات، فما يُصلح حال المسلمين هو نفسه ما يُصلح حال المسيحيين، وهو نفسه ما يصلح حال الملحدين، وهو نفسه ما يصلح حال السوريين، وهو نفسه ما يصلح حال غيرهم من الشعوب أو أيّ اجتماع بشري، فوفقًا لابن القيم الجوزية (أينما يكون العدل، فثَمّ شرع الله).
———————————
الهندسة السياسية لإنتاج توافقات وطنية سورية/ عبد الحميد عكيل العواك
منذ بداية الثورة والوثائق تصدر تباعاً وكأنَّنا في سباق محموم لإصدار وثائق تُعبِّر عن وجهة نظرنا، وهذا طبيعي لشعب حُرم من التعبير عن وجهة نظره، ولكن بعد كل تلك السنوات يجب الانتقال إلى الضفة الأخرى ومعرفة ما لديها ليس بغرض النقد، بل بغرض البناء على نصوص وحلول توافقية.
وآخر تلك الوثائق صدرت عن (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) بعنوان: “مشروع وثيقة توافقات وطنية” وهي وثيقة تمَّ تصنيفها بأنَّها (مشروع متكامل) وتطمح أن تكون سفينة نجاة تحمل خشبة الخلاص للسوريين، إذ عُقد لأجلها 26 جلسة حوارية على مدى 13 شهراً، نوقشت فيها 12 قضية منها ما هو خلافي، وشارك 186 سوريًا في الحوار.
و(مركز حرمون) مشكوراً يطرح هذه الوثيقة للحوار والمناقشة، لكنني في هذا المقال لا أريد الدخول في مضمون الوثيقة؛ لأنَّ كل نقطة وردت تحتاج إلى وقفة مطولة، غير أنه من المناسب الوقوف عند الإطار العام فقط!
ننطلق من عنوان الوثيقة “توافقات وطنية” إذاً هناك إقرار بانقسامات داخل المجتمع السوري، وهي حقيقة واقعية، فالمجتمع السوري يعاني من انقسام عمودي يتمايز الناس فيه تبعًا لهوية يرثونها من آبائهم، مثل انتماء الفرد إلى دين، أو قومية، أو قبيلة، أو جنس.
ومن انقسام أفقي، حيث يتمايز الناس تبعًا لهوية يكتسبونها باختيارهم، مثل انتماء الفرد إلى حزب، أو حرفة، أو أيديولوجيا..
غير أن الإقرار بهذين الانقسامين لا يكفي، ما لم تكن هناك حلول توافقية، فهل استطاعت الوثيقة أن تتناغم مع عنوانها وتحقق ذلك؟
حيادية مراكز الدراسات ومسؤوليتها
في ظل غياب الأحزاب الفاعلة والمؤثرة في المجتمع السوري المعاصر، تتضاعف مسؤولية مراكز الدراسات في القيام بالتنشئة السياسية والاجتماعية، وتقريب وجهات النظر، لأنَّ تحقيق التنمية السياسية في المجتمع يعني بالضرورة حلّ الأزمات التي تواجه النظام السياسي، والتي تعدّ من أبرز سمات التخلف السياسي، وهي (أزمة الهوية)، التي يترتب عليها غياب الولاء للوطن، و(أزمة الشرعية)، التي تعني عدـم قبول المواطنين بالنظام الحاكـم، و(أزمة المشاركة) التي تدل على تغييب الناس عن مسرح العملية السياسية.
لذلك تعمد مراكز الدراسات لخلق ثقافة جديدة وذلك بإدخال أنماط جديدة من الثقافة السياسية القائمة، لأنَّ مجتمعات ما بعد النزاع تحتاج دورًا فعّالاً إيجابيًا في تهيئة الظروف الملائمة التي من شأنها خلق مناخ يسوده السلم ونبذ العنف وعدم تكرار التجارب الماضية المؤلمة، لأنَّ مرحلة ما بعد النزاع تحتاج أفكارًا جديدة غير مطروقة سابقًا من النظام ولا من أطياف المعارضة، بل تحتاج أفكارًا إبداعية تنبع من المجتمع وتعود إليه بصياغة يرتضيها الجميع.
لذلك ما كنَّا ننتظره من الوثيقة هو إبداع توافقات جديدة، بحيث يجد الجميع نفسه فيها، لكن الحقيقة المرة أنَّ الوثيقة عبَّرت عن وجهة نظر أحادية واضحة لكل سوري، ومن السهل جداً أن تتبنى وجهة نظر فريق وتعرضها في دراساتك، وهذا ما فعلته الوثيقة، ولكن الصعوبة تتأتى في جمع المتناقضات بنص واحد يرضى به الجميع، وهو ما لم تفعله الوثيقة.
ولأنَّ الشجاعة لا تأتي بطرحك لوجهة نظرك بقوة، بل تكون بالاستماع للمختلف عنك بشغف موصول برغبة بإنتاج الحل، ومركز الدراسات ليس حزبًا سياسيًا يعرض وجهة نظر واحدة ويسوّق لها، بل هو منظمة حيادية، وصفة الحيادية قادمة من صفة الباحث والبحث العلمي، لذلك هو أقدر على تقديم الحلول للإشكاليات المزمنة والمستعصية.
إن الذي يريد أن يسهم في الحل عليه أن يبتعد عن إقصاء الآخرين، وألَّا يتذاكى في تلك اللعبة “لأنَّ لعبة الذكاء بين الأذكياء ضرب من الغباء” ولا سيما لدى سوريين أصبحوا خبراء في فنون الإقصاء، على امتداد زمني عايشوا فيه “نظامًا” مارس أشدَّ صور الإقصاء وأعنفها، وبكلِّ مكر كان يعطي الآخرين في وثائقه جوائز ترضية، لا قيمة لها على أرض الواقع، وهو ما لم تفلح به الوثيقة فامتنعت حتى عن تقديم جوائز الترضية للآخر.
أول مراحل التغيير هي الوعي بالواقع السوري الذي يختلف عن غيره، وهذه سمة طبيعية في المجتمعات، إذ ليس هناك مجتمع ديمقراطي واحد، بل هناك مجتمعات ديمقراطية متنوعة، وفق ما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في معظم قراراتها.
ودراسة تاريخ الأمم تعلمنا أنَّ المجتمعات القوية بدأت قوتها بتأسيس المشتركات بينها وإبداعها في ذلك، وليس في استجرار تجارب الآخرين، أو تجاهل المختلفين معها بالرؤية، من يقرأ وثائق التأسيس الأميركي والثورات البريطانية وتطورات فرنسا منذ الثورة حتى اليوم، يدرك كيف يكون البناء على المشتركات وخلق وإبداع الحلول، وليس التسابق والتذاكي في صناعة وجهة نظر أحادية وتجاهل الآخر، وهنا أعني به جميع من صنع الوثائق من السوريين، في استعراض الوثائق السابقة لا نجد صياغة تجمع المتناقضات وترضي الأطراف ويجد الجميع نفسه بها.
آلية صناعة وثائق التوافقات ما بعد النزاع
إذا كان التصور التقليدي لمفهوم النزاع هو (ربح-خسارة) فإنَّ خبراء حل النزاعات المعاصرين يركزون على المبدأ الأنسب الذي هو (ربح-ربح) من خلال التعاون بين الأطراف المتنازعة ومراعاة مصالحهم والبحث عن الطرق التي تلبي هذه المصالح حتى يقبل بها كل الأطراف.
كان يجب أن تركز “وثيقة التوافقات الوطنية” في هذه المرحلة على صياغة تقلل من التوتر وتُعيد للعلاقات الاجتماعية والسياسية استقرارها، وتُبعدها عن الاستقطاب الحاد، لأنَّه في غير ذلك لن يقف السلوك العنيف في المجتمع.
نعم يمكن أن تؤثر الثقافة السائدة على مستقبل سوريا، لكن يقع على عاتق مثل هكذا وثائق التركيز على حل المشكلات، والمضي نحو علاقات مستقبلية طيبة مبنية على التوافقات، هذا البناء لا يتم في استجرار مفاهيم سائدة ومعلبة وجاهزة، بل في إبداع حلول جديدة وأفكار غير مسبوقة.
حتى ننتقل من إطار النقد إلى اقتراح الحلول لهندسة سياسية لإنتاج وثائق التوافقات
أول الخطوات هي أن نُؤمن أنَّ جميع الأفكار السابقة “المنفردة” كانت جزءًا من الإشكالية ولا تصلح بفردانيتها لأن تكون جزءًا من الحل، لذلك فإنَّ البناء على منظومة قيمية سابقة سواء كانت للنظام أو لجزء من المعارضة هو بناء من رمل وعلى رمل سرعان ما يتهدم.
حري بالجهة المبادرة لإنتاج وثيقة توافقات، مركز حرمون في حالتنا هذه، ألَّا تدعو للحوار جهة واحدة بل دعوة جميع من يمتلك وجهة نظر ويدافع عنها وتكون المرحلة الأولى من الحوار بتدوين جميع الآراء وفرزها إلى مجموعات، وفي المرحلة الثانية يدافع كل فريق عن أفكاره أمام الآخرين المستمعين له، أما المرحلة الثالثة فتخصص لنقد كل فريق للآخر، وفي هذه المراحل الثلاث تحافظ الجهة الداعية على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع.
أما المرحلة الأخيرة وهي الأصعب فيظهر دور الجهة المبادرة في صياغة التوافقات، واقتراح الحلول الممكنة التطبيق، وتجسير الهوة بين الأطراف، وفي حال عدم الوصول لنص توافقي تعرض وجهات النظر المتباينة، وهذا درو المركز الريادي.
وعلينا أن نعلم جميعاً أن دساتير ما بعد الصراع تقترح حلولًا ولا تجتر مبادئ سابقة من دول أخرى، هكذا فعلت أميركا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا؛ لأنَّ هذه الدول تعلم جيداً أنَّ الدساتير أكثر أهمية من تشكيل الحكومات، وتنظيم العلاقات بينها وبين المواطنين، فالدساتير أدوات مهمة لإدارة الأزمات والمصالحة بين الجماعات والمجموعات الأيديولوجية ومعالجة الظلم غير المقبول.
—————————
ملاحظات على مشروع وثيقة توافقات وطنية/ د. مخلص الصيادي
قرأت هذا المشروع من مقدماته، وأسماء المشاركين، والملاحظات على علاقة المشاركين بالنص المقترح، وصولًا إلى متن المشروع.
وما معمول به في التعليق على مشروع ما، أن نستعرض الملاحظات الجزئية، نقدا أو إشادة قبل أن نجمل ذلك بعرض الموقف أو التقييم العام.
وأمام هذا المشروع المقدم، فإنني أبدأ بعكس هذا المعهود لأسجل:
أن هذا المشروع لا يصلح لأن يكون وثيقة ل “توافقات وطنية” يلتقي حولها السوريون، بل إنه لا يصلح لأن يكون قاعدة أولية للحوار، لأسباب عديدة أهمها أنه يفتقد لعرض ما يشغل القطاع الأوفر من السوريين بشأن مستقبلهم، ومستقبل وطنهم، بل إن التدقيق في النصوص الواردة يشي بأن المشروع المقترح يستبطن إستخفاف بوعي وإدراك هذه القطاع حين يدعو في غير موضع إلى مراعاة الأغلبية الإسلامية، وإلى ضرورة اختيار الفاظ وصياغات لا تثير هذه الأغلبية.
ثم إن هذا المشروع يحتوي على مجموعة من التناقضات لا يمكن تغطيتها، وهذه تزيد من حدة الخلاف حوله، بدل أن يكون بحق مشروعا لتوافقات وطنية، وفي هذا التعليق ليس مفيدا الوقوف على كل نقطة، وكلمة، ويكفي أن نقف على بعض الإطارات العامة التي أرجح أنها ستكون مانعا من النظر والتفاعل مع هذا المشروع باعتباره” وثيقة توافقات” كما أراد معدوه، الذين أحسنوا إذ لم يرجعوا النص إلى المشاركين في الحوار، وإنما للجهة التي وضعته مستفيدة من الحوارات والآراء، لكنها هي وحدها المسؤولة عنه.
1ـ الحديث عن قواعد فوق دستورية ضابطة للدستور، وتوفر قاعدة استقرار قانونية للوطن والمواطن، حديث غير مفهوم، لأنه غير محدد، وغير معروف موقعه من الدستور، هل هذه القواعد متضمنة فيه؟، هل هي حاكمة له؟ هل توضع خارج الدستور ويصار إلى الاستفتاء عليها؟ أم توضع في مقدمة الدستور؟ وهل تخضع للآلية نفسها التي تخضع لها مواد الدستور من حيث التغيير والتعديل؟، أم يصار إلى تعديلها وتغييرها وفق آلية خاصة مستقلة.
وإذا كان لهذه المواد صفة الهيمنة على المواد الدستورية الأخرى، فما معنى القول “بقابليتها للتجميد”، ومن يقوم بتجميدها!، والمشروع يصفها ويضعها في خانة ” فوق الدستورية”.
2 ـ القول بأن ” القواعد الدستورية المحصنة، فوق الدستورية ” تعالج المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات السورية ” تحديد مبدئي مهم، وهو إذ يوفر معيارا عمليا للتفكير وللحركة، لكنه كما هو واضح من نصه يستدعي تحديدا للمسائل الخلافية الكبرى بين مكونات المجتمع السوري. فما هي المسائل الخلافية الكبرى في المجتمع السوري؟
وكيف السبيل الى تحديدها؟
والإجابة على التساؤل الثاني هو الأهم، لأنه المدخل لتحديد هذه المسائل.
هل نلجأ إلى استطلاع مواقف المفكرين والتيارات والفصائل السياسية في سوريا، أو نلجأ إلى جمهور الشعب السوري، والجمهور المعنى هنا هو الأغلبية بمكنوناتها الوطنية المختلفة.
وإذا كان اللجوء إلى الأفراد والأحزاب من شأنه تشتيت الجهد، خصوصا وأن نظام الحكم الاستبدادي الطائفي شوه الحياة السياسية في سوريا، وأفقرها، وصحرها، فإن أمامنا مقياسا تَمردَ على تلك القيود التي نتجت عن ذلك النظام المستمر منذ أكثر من خمسة عقود، وهذا المقياس نجده بسهولة ويسر في الحراك الثوري السوري، في الثورة السورية، وشعاراتها التي سيطرت على الشارع السوري، من درعا إلى الساحل إلى حلب، ودير الزور، مرورا بكل المحافظات السورية، وقد شاركت في هذا الحراك الثوري كل المكونات العرقية والقومية والدينية والمذهبية والمناطقية.
هل رفعت في تلك المرحلة أي شعارات تجزئ وتقسم الشعب السوري، أو تشكك بهويته العربية الإسلامية، أو تطالب بتغيير العلم السوري، أو تطالب بحذف المادة الخاصة بدين رئيس الدولة، أو تعلن كفر النظام ورئيسه، أو تطالب بتغيير قوانيين الأحوال الشخصية… الخ.
في حدود علمي لم يرفع أحد شعارات من هذا القبيل، حتى المكون الكردي في الجزيرة الفراتية وريف حلب وإدلب لم يخرج عن المطالب الوطنية العامة، لكنه شدد على مطالبا برفع غبن وقع عليهم، وسياسة جائرة ارتكبت بحقه، تم تنفيذها خصوصا في عهد البعث.
وحينما شاركت الفصائل الكردية المختلفة في التكوين الأول لهيئة التنسيق الوطنية شاركوا في إطار هذا الموقف الوطني العام.
إذا أردنا أن نستخلص قواعد فوق دستورية تحصن الدستور فلنمعن النظر والتدقيق في الحراك الثوري الأول، فهو ما يمثل منجاة للوطن والمواطن.
إن تغييب هوية المجتمع ليس سبيلا لتحقيق إجماع وطني يصون سوريا، ويبني مستقبلها، وإنما تَمَثُل هذه الهوية في أي برنامج بناء وطني هو ما يبني المستقبل السوري، ويصونه.
والهوية ليست امتيازا، ولا تعطي أحدا حقوقا على حساب أحد، ولكنها تحدد اتجاه التطور والعمل والتفاعل داخل المجتمع.
الامتيازات يعطيها الدستور، وتعطيها القوانين، على قاعدة تمايز العمل الفردي، وعلى قاعدة الاحتياج الإنساني الفردي، وعلى قاعدة الوظيفة الاجتماعية المختلفة، الامتيازات “تعطى للعالم ولصاحب الجهد المميز، تعطى لأصحاب الاحتياجات الخاصة، تعطى للمرأة والطفل”، ولا تعطى على قاعدة الاختلافات العرقية أو الدينية أو المذهبية، والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات هو ما يصون الحياة الاجتماعية.
واضح أن الوثيقة تشعر بحرج إزاء ما تطرحه بشأن الهوية، وبأنه بعيد كثيرا عن الواقع السوري، لذلك تذهب إلى التشديد على ضرورة ” التأكيد الدائم على الانتماء الثقافي للحضارتين العربية والإسلامية”، إن هذا النص المضطرب يدفع لفتح الباب واسعا للبحث في تحديد معنى الحضارتين: العربية والإسلامية!
2 ـ يسود الوثيقة فكر علماني صرف، يراد له أن يسود في كل أنحاء المجتمع، بل وأن يفرض على المجتمع، فالوثيقة المقدمة تعترف بأن الأغلبية في المجتمع السوري مسلمة وعربية، وهي تحاول مواجهة هذه الأغلبية بالدعوة إلى تخفيف العبارات، وعدم الأخذ بالنصوص القاسية، وبتدوير الزوايا حتى يتم تمرير هذه العلمانية، هذا موقف غير سوي تنتهجه الوثيقة المقدمة، فيه كثير من الاستهانة بوعي الناس وفهمهم.
كان أفضل وأكثر مصداقية أن تقول الوثيقة إننا نتبنى العلمانية ولا نرى سبيلا غيرها، وإن علينا أن ندفع الناس للقبول بها، وقد ذكر مثل هذا التصريح في فقرات لاحقة، لكن بشكل مخفف.
وكمثال على هذه العلمانية الصرفة فإن هذه الوثيقة تدعو إلى تحرير الدستور حتى من ” قوانين الأحوال الشخصية” التي تستند بالنسبة للمسلمين على الشريعة الإسلامية، وإذ تشعر بصعوبة قبول هذا العرض تدعو إلى تقديم نصوص قانونية تسمح للفرد أن يختار بين قوانين العلمانية الصرفة، أو قوانين الشريعة، والأحوال الشخصية الخاصة بمذهبه ودينه، وهذا الخيار مجرد خطوة مرحلية.
ومن هذه العلمانية أيضا تدعو الوثيقة إلى تمرير ما ورد في منظومة حقوق الانسان مما يخالف الشريعة بشكل تدريجي يسهل على جمهور وطننا قبولها، ولعل الوثيقة تذهب هنا الى ما يخص” قضايا الشذوذ بأشكالها المختلفة، والأشكال المختلفة المزعومة للأسرة، والجندرة، والجنس العابر….. الخ”.
والوثيقة تعترف بأن هذه المسائل التي تدعوها بالحقوق الإنسانية الدولية “تعارض ثقافة المجتمع وقيمه السائدة، أو تعارض بعض العادات والتقاليد والأعراف القارة في وجدان الناس”.
3ـ تتحدث الوثيقة في شكل الدولة في سوريا الجديدة عن اللامركزية الإدارية الموسعة، وهذا شعار أو حديث مغرٍ جدا للكثيرين، لكن في الحقيقة غير مفهوم، لأنه غير محدد بشكل واضح.
إذا كان يختص بالتنمية الكفؤة، والمتوازنة، للمجتمع السوري فليس في هذا الطرح أي إشكال، بل لنقل، بأنه طرح لا ضرورة له، لأن نظاما وطنيا يخضع لإرادة الناس، لابد أن ينزع إلى نظام لا مركزي يكون أكثر كفاءة وانتاجية من النظام المركزي.
لكن مثل هذا النظام محدد بدقة وبحسم، وهو وسيلة للتنمية والتقدم، وليس خطوة نحو التقسيم والتفتيت للجغرافيا الوطنية، وللجسم الوطني.
وحتى تتحقق هذه الرؤية فلا بد أن يضمن هذا النظام:
** عدم خضوع تقسيم الدولة إلى إدارات لامركزية محلية إلى أي اعتبارات عرقية، أو دينية، أو طائفية، أو جهوية، أو قبلية، وإنما فقط لاعتبارات تنموية نهضوية.
** ضمان حرية المواطن السوري في الانتقال والعمل في أنحاء سوريا، لا يمنعه عن ذلك اختلاف في الدين، أو العرق، أو المذهب، أو اللون، أو الأصل.
** وضمان حرية المواطن السوري في التملك في أي بقعة من الأرض السورية لا يمنعه عن ذلك أي مانع، ما دام يحمل الجنسية السورية، ويخضع للقوانين السورية.
** وتوفير حرية المواطن السوري في الانتساب إلى أي حزب، أو جمعية سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، دون تمييز، ما دامت تتوفر فيه شروط العضوية العامة التي لا تخضع لغير مفهوم المواطنة.
** وأخيرا أن يكون ذلك كله في إطار خضوع جميع التقسيمات الإدارية المقررة في هذا الشكل من الحكم، للسيادة الوطنية العامة.
4ـ تعرض الوثيق مفهوم أن “العلمانية تحارب الطائفية” وهي سبيل للقضاء عليها، ولا تقدم أي دليل أو إشارة لصحة هذا المفهوم، لا من المفهوم نفسه، ولا من التجارب الإنسانية، ولا مما تطرحه هي من أفكار ومفاهيم، ويكفي الإشارة هنا إلى دعوتها لاعتماد مفهوم “لين” للعلمانية، وإلى ضرورة إيجاد صيغ مرحلية قانونية وتشريعية تراعي الحساسية الخاصة الدينية والمجتمعية لمعظم السوريين، وإلى ضرورة التوكيد على الصلة بالحضارة العربية والإسلامية، والى إيجاد تمرير مفاهيم ” الحقوق الدولية” على المواطن السوري بالتدريج،… الخ
وكل هذه التفاصيل تؤكد الاعتقاد الراسخ لدى واضعي هذه الوثيقة أن “الناس” ليسوا مع هذا الطرح، ليسوا مع العلمانية، وأن “العلمانية المقصودة” ستزيد السوريين انقساما، وتفرق بينهم بدل أن تجمعهم وتشد أزرهم.
ثم إن الوثيقة لا تقدم مفهوما مدركا لحياد الدولة تجاه الأديان والمذاهب، غير قولها بتحريم الأحزاب القائمة على أساس ديني أو مذهبي، وتحريم قيام مثل هذه الأحزاب لا صلة له بالعلمانية، وإنما صلته بمفهوم المواطنة، إذ من حق المواطن أن ينتسب إلى أي حزب سياسي يعمل على أرض الوطن، لا يمنعه عن ذلك انتماء ديني او عرقي أو مذهبي، وقد يكون المناسب أن نذكر هنا أن حزب مثل “حزب الحرية والعدالة” الذي شكله الاخوان المسلمون في مصر عام 2011 كان مفتوحا للمسلمين والمسيحيين، وكان المفكر المصري المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب .
إن واضعي هذه الوثيقة لم يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تكون الدولة حيادية تجاه الدين الإسلامي!.
في الدين المسيحي الكنيسة مؤسسة مستقلة عن الدولة في كل شيء تقريبا، وهي تقدم خدماتها للمواطن الغربي وتستجيب لاحتياجاته، ومع ذلك يندر في الدول الغربية أن ترى الدولة منفصلة تماما أو مستقلة تماما عن الكنيسة، ولمن يريد أن يتأكد من ذلك فليراجع دساتير الدول الأوربية العلمانية، لكن في دولة الإسلام دين غالبة شعبها، كيف يمكن أن يحدث هذا الفصل؟
حالة واحدة يمكن أن توفر هذه الاستقلالية أو نوع منها، وهذه الحالة تتحقق بوجود “مؤسسة كنسية للدين الإسلامي” ولما كان هذا مستحيلا، فإن الحيادية شعار مستحيل التطبيق في مثل مجتمعاتنا، والذي لا يدرك هذه الحقيقية عليه أن يدرس التجربة التركية القاسية والدامية في هذا المجال، ومآلاتها.
5 ـ من الغريب أن يتم طرح قضية “معالجة الأزمة القومية بين القوميتين العرب والكرد”، إن هذا الطرح يشعر بأن هذه ” الأزمة” عنصر رئيسي في ” الملف السوري” يحتاج إلى معالجة خاصة، وهذا تدليس في عرض الحقيقية.
نحن لا نقول إنه لا توجد أزمة، لكن ليس بين العرب والكرد، وإنما هناك أزمة بين جماعة انفصالية كردية مرتبط بحزب كردي انفصالي موصوف بالإرهاب، يمارس افعاله الإرهابية ضد الكرد والعرب على السواء، ومرتبط بدول ومشاريع غير وطنية، ثم هناك مشكلة لها ظلالها العرقية بين نظام البعث والمكون الكردي وخصوصا في الجزيرة وأرياف حلب وادلب، ولعل ما قام به نظام “بشار الأسد” من ظلم وقهر للسوريين وحد الجميع وفرض عليهم الاتجاه معا نحو بناء سوريا الديموقراطية الموحدة لكل أهلها ومكوناتها. وعلى السوريين أن يكونوا مستعدين لمعالجة هذه القضية، من هذه الزاوية تحديدا خلال معالجتهم لمختلف الأزمات الاجتماعية والإنسانية والسياسية التي خلفها نظام البعث.
6 ـ كان مهما لمثل هذه الوثيقة أن تذكر معيارا لوصف مجتمع ما بأنه مجتمع متعدد القوميات ـ وهو وصف أطلقته على المجتمع السوري. وجود المعيار مهم لفهم المقصود، ولتحديد الحالة والمشكلة.
التنوع في سوريا مشهود، لا يحتاج إلى دليل، لكن وصف هذا التنوع الديني والعرقي والمذهبي، بأنه يرسم صورة مجتمع متعدد القوميات يحتاج إلى تدقيق علمي.
ما هي النسبة التي يجب أن تتوفر لأي أقلية حتى يتحول معها المجتمع الذي تعيش فيه، وتنتسب مواطنة إليه بأنه مجتمع “متعدد القوميات”.
السؤال هنا ليس ترفا، ولا من قبيل البحث النظري، وإنما سؤال جوهري تتولد عنه سياسات وميزانيات، ومواقف.
هل توفر نسبة تسعين بالمائة من قومية واحدة في بلد ما، وتوزع العشرة بالمائة الباقية بين عدة قوميات أخرى، يتيح تسمية هذا البلد بأنه متعدد القوميات.
هل الأخذ بتسمية “متعدد القوميات” يفرض أن تتعدد اللغات المعتمدة في هذا البلد على قاعدة المساواة، فيصبح للبلد الواحد ثلاث أو أربع لغات أو خمس لغات، بعدد هذه “القوميات”.
وبالمثل وللقياس فقط، هل علينا أن نناضل لنجعل اللغة العربية، وهي لغة أكثر من خمسة ملايين شخص، لغة ثانية في فرنسا البالغ عدد سكانها 68 مليون نسمة، مساوية للفرنسية في الحقوق، أو أن نجعل اللغة التركية لغة ثانية في ألمانيا مساوية للألمانية في الحقوق، واللغة العربية لغة ثالثة فيها، خصوصا وأن عدد الأتراك في المانيا وصل إلى أكثر من تسعة ملايين تركي، وعدد العرب فيها وصل إلى مليون ونصف المليون عربي، فيما عدد سكان المانيا 82 مليون نسمة.
أم أن هناك ضوابط لابد من توفرها حتى نطلق هذه الصفة” دولة متعددة القوميات”، وأنه بناء على هذه الضوابط تتحدد الواجبات، والطريقة التي يتجلى فيها هذا التعدد.
لقد كان أجدى لمثل هذه الوثيقة أن تقدم علاجا لهذه المسألة بدل أن تعتمد توصيفات تفتقد لأي أساس علمي أو عالمي معتمد.
7 ـ ولقد كان ملفتا أن الوثيقة تقول لا للنظام الرئاسي لأنه كنظام ، كان مدخلا للحكم الاستبدادي، وتقول لا للنظام البرلماني متذرعة بأن ظروف سوريا لا تتحمل نظاما برلمانيا، وتدعو إلى نظام مختلط، يحمل بعضا من صفات النظامين، لكن الوثيقة لم تقدم توصيفا أو تعريفا أو تحديدا لهذا النظام المختلط.
والقضية هنا ليس فقط في تسجيل القصور في هذا الجانب، وهو جانب كان يجب أن يبذل فيه جهد حقيقي، لأنه يمثل إذا تحقق مساهمة فعالة، نقول ليس الأمر هنا في تسجيل القصور، وإنما في أن بحث هذه المسألة، وكثير غيرها مما يخص الجانب القانوني والدستوري في الدولة، يشعرنا بأن الأزمة في سوريا منبعها “دستوري، قانوني”، وهذا غير حقيقي أبدا، ولا أظن أن أحدا في المعارضة يعتقد حقا أن منبع الاستبداد قصور في النصوص الدستورية، أو أن هذه النصوص تسمح “للرئيس” أن يتحول إلى مستبد.
إن المدخل الحقيقي للاستبداد في سوريا ـ وهي هنا مجال بحثنا ـ ليس في النصوص الدستورية والقانونية على أهميتها، وإنما في رمي هذه النصوص في سلة المهملات، وإطلاق إرادة الحاكم، ومن حوله، وتغوله على كل نص قانوني، دون خشية من عقاب أو مسؤولية.
إن تغيير النص الدستوري في سوريا أسهل من تغيير أي شيء آخر، والاستهتار باستقلالية القضاء أيسر من الاستهتار بأي شيء آخر.
في العام 2000 كان الدستور السوري في نظام الأسد الرئاسي يحدد عمر رئيس الجمهورية، وتم تغييره خلال دقائق، وقبل ذلك بواحد وخمسين عاما كان في سوريا نظاما جمهوريا برلمانيا وليس رئاسيا، ومع ذلك تحرك الجنرال حسني الزعيم وافتتح طريق الانقلابات العسكرية. وفي كل هذا التاريخ لم تشهد سوريا تقاليد معتمدة في احترام استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات.
القضية أعمق من النصوص، وإن كان لابد من هذه النصوص، لكن لا يجوز اعتبارها واقيا يقي من التغول في الصلاحيات، والعدوان على حقوق المواطنين وحياتهم، وثروات الوطن.
8 ـ تبقى هناك قضية جوهرية غفلت عنها هذا الوثيقة المقترحة، وهي ذات وجوه عدة: وطني سوريا، وقومي عربي، وديني حضاري، وتحرري إنساني، وهي قضية الجولان السورية المحتلة، وقضية فلسطين، ومن الغريب أن تغيب هذه القضية نهائيا، وكان في غيابها تسليم بهزيمة سوريا وخروجها من جغرافيتها السياسية وانتمائها الحضاري، ومسؤوليتها تجاه أرضها الوطنية.
ليس مطلوبا من وثيقة كهذه أن تدخل في تفاصيل هذه القضية، في هذه المرحلة بالذات، لكن الموقف المبدئي أكثر من ضروري، لأن في غيابه إعلان بانتصار إرادة العدو الصهيوني في تعطيل، وشطب الدور السوري، وإخراجه من ساحة الفعل.
ولأنني لم أطلع على كامل المداولات التي تمت على مدار نحو عام ونصف العام، وهي المدة التي انتجت في الختام هذه الوثيقة، ولأن كثير ممن ذكرت أسماؤهم كمشاركين في هذه المداولات تعتبر هذه القضية حاضرة بقوة في فكرهم السياسي وتاريخهم النضالي، فإني أفترض أنها غيبت من قبل معدي هذه الوثيقة، ولم تكن غائبة في مداولاتها.
إذا كان تقديري لطبيعة المشاركين والمساهمين الذين بلغ تعدادهم 186 سوريا وسورية، وانتماءاتهم صحيحا، فإن جانبا من الخلل في مخرجات هذه الجلسات الحوارية يعود إلى اقتصار المشاركين على طيف محدد من السوريين، وغياب أصحاب راي من غير الاتجاهات الموصوفة في هذه الوثيقة، وحتى في إطار هذا الطيف المحدد أرجح أن الوثيقة لم تستوعب جميع الآراء والاتجاهات التي عرضت خلال تلك الجلسات.
—————————-
ملاحظات على مشروع وثيقة توافقات وطنية للمعارضة السورية/ مازن كم الماز
أصدر الوثيقة مركز حرمون بمعية 186 من “السوريين المؤمنين بسوريا حرة مستقلة ديمقراطية حديثة” , “من مختلف الاختصاصات و الانتماءات” تهدف الورقة إلى وضع “قواعد دستورية يتوافق عليها السوريون و يعطونها حصانة استثنائية ضد التعديل أو التغيير” ، هذه “القواعد الدستورية المحصنة أو ما يعرف عالميًا بالمبادئ فوق الدستورية” , يفترض أن تعالج هذه القواعد “المسائل الخلافية الكبرى بين الجماعات السورية و تعالج مخاوفها و هواجسها المختلفة بشأن حقوقها و حرياتها و مستقبلها” إننا أمام مجموعة من البشر ، من السوريين ، تمنح نفسها وضعًا استثنائيًا ، الحق في أن تحدد للآخرين قواعد لا يحق لهم مناقشتها أو نقدها أو تغييرها … يأتي هذا من أشخاص ينتقدون النظام الأسدي لمصادرته الحياة السياسية و حريات الناس و حقوقها لينتهوا هم أيضًا إلى فرض وصايتهم الخاصة على السوريين و على حقهم في الاختلاف و الاختيار و حتى النقاش عندما يتعلق الأمر بأهم المبادئ و القواعد التي يفترض أن تقوم عليها حياتهم … و تشتمل هذه “القواعد الدستورية أو المبادئ فوق الدستورية” على أغلب ما هو سائد و رائج اليوم في التداول السياسي العالمي كما السوري النخبوي : سيادة القانون ، الفصل بين السلطات ، استقلال القضاء ، اجتثاث شأفة الطائفية الخ ، أما كيف سيمكن تحقيق كل هذا فهذا سؤال يبقى عمليًا بلا جواب شافي … ترى هذه المجموعة أن “سيادة القانون ( ستكون ) حجر الأساس في بناء الدولة السورية الحديثة ، دولة القانون و العدالة و الحقوق و المواطنة و المؤسسات” ، أما ما هي الطريقة لفرض سيادة القانون خاصة على من يملك وسائل العنف و يحتكرها في مناطق نفوذه و سيطرته فهي كالتالي : “نص دستوري” , “قواعد فوق دستورية محصنة” , “تشريعات مفصلة” , “تحديد دور و وظائف مؤسستي الأمن و الجيش” … نفس الكلام سيتكرر عند الحديث عن فصل السلطات ، استقلال القضاء الخ ، و كأن رفع الشعار لوحده يكفي لكي يصبح واقعًا… الحقيقة هنا أن قوى الأمر الواقع المسيطرة في سوريا بدءًا بالنظام إلى قسد وصولًا إلى هيئة تحرير الشام و الجيش الوطني المرتبط بتركيا لا تزعم أبدًا أنها ضد أي من هذه الشعارات و تردد أنها تلتزم في مناطق سيطرتها باستقلال القضاء و سيادة القانون الخ الخ دون أن يعني ذلك شيئًا على أرض الواقع … إننا أمام مشروع معلق في الهواء لا يرتكز على أية أرضية و هو يهرب إلى الأمام عبر اقتراح قواعد فوق دستورية لن تكون أكثر من مجرد شعارات يمكن لأية قوة مسيطرة على الأرض أن تنتهكها و تضرب بها عرض الحائط بينما يمكنها أن تزعم أنها تحترمها و تخضع لها… و لا تتوقف هذه النزعة النخبوية الفوقية المهيمنة على الوثيقة هنا ، فما يسميه هؤلاء قواعد دستورية تمنح “الدولة” صلاحيات خاصة جدًا و استثنائية في تطبيق و تنفيذ هذه القواعد و تضعها في مركز سوريا “الحرة المستقلة الديمقراطية و الحديثة” فالدولة هي التي ستقوم بتبني شرعة حقوق الإنسان العالمية و تكرسها دستوريًا و قانونيًا و هي التي ستعالج مسألة تعارض بعض هذه الحقوق مع ثقافة المجتمع و قيمه السائدة أو مع بعض العادات و التقاليد ، و هي المسؤولة عن إقناع الناس بها ، المقصود هنا بالناس السوريين المحكومين ، و هي التي ستقوم بنشر الوعي بين السوريين عن نمط الحكم الأمثل و عن أخطار الطائفية و مآلاتها الكارثية على الوطن و الوعي بقيم المواطنة و النموذج الاقتصادي الاجتماعي الذي اختاره واضعو الوثيقة “يحتاج أيضًا إلى دولة ذكية” إننا أمام مشروع دولتي فوقي بامتياز يمنح الدولة و نخبتها الحاكمة نفس صلاحيات و “مهام” ديكتاتورية البروليتاريا في الماركسية الستالينية و الدولة الامبراطورية في الفكر السياسي الإسلامي و القومي الشوفيني … و ما عدا بعض السطور عن المجتمع المدني و عن نظام اقتصادي مبهم أشبه باقتصاد السوق الاجتماعي الذي تحدث عنه النظام نفسه منذ التسعينيات و الذي يشكل سياسته الاقتصادية المعلنة منذ 2005 ، و عن دور التعليم في إنجاز كل هذه المهام المفترضة فإننا نقف بالكامل أمام مشروع دولتي يؤسس لذاته على أساس إيديولوجي بحت ، شعاراتي ، مستوحى من الفكر السائد أو المهيمن عالميًا ، دون أية نقطة ارتكاز واقعية أو فعلية سوى مؤسسات الدولة و وظائفها القمعية أو القائمة على القسر و الإكراه … هذا يعكس في الواقع القصور العميق الذي بدا عجزًا في فكر الجزء الأكبر من المعارضة السورية التي كانت تصف نفسها بالديموقراطية قبل 2011 ، بل في مجمل مشروعها الذي لا يستند إلى قراءة تاريخانية ، حسب مصطلح عبد الله العروي ، أو اجتماعية عن النظام الديمقراطي و خلفياته الاجتماعية و أزماته المتفاقمة و النقد الهام ، خاصة اليساري ، لأطروحاته و ممارساته.
—————————-
رسالة مفتوحة حول مشروع وثيقة توافقات وطنية/ معقل زهور عدي
تحية طيبة :
أحب أن أحيي جميع من ساهم في إخراج هذه الوثيقة وهي خطوة هامة في مسيرة الألف ميل , تبعث الأمل ببث الروح مجددا في الحياة السياسية والفكرية لسورية والتي أصابها ما أصاب الوطن والمجتمع من جراح عميقة وتمزق وانتكاس .
باختصار أود أن أضع عدة ملاحظات أمام اهتمامكم بتلخيص شديد:
الملاحظة الأولى: ضرورة التمسك بكون الوثيقة مفتوحة للنقاش فهي ليست نصًا مكتملًا بقدر ماهي أداة للحوار الواسع قابلة للتعديل والتطوير، فمازلنا بعيدين عن الوصول لما يمكن أن يوصف بوثيقة تصلح لتكون محط توافق وطني شامل.
ومن أجل الإبقاء على زخم ذلك الإنجاز الهام لابد من إثارة النقاشات حوله ضمن أوسع الدوائر الشعبية والثقافية ورصد ردود الأفعال والملاحظات بروح الانفتاح وتقبل مختلف الآراء.
ثانيًا: سوريتنا جريحة ومتمزقة كما لم تكن في أي وقت، فمن الضروري البحث عن الصيغ التي تفيد في التئام الجراح والابتعاد عن الصيغ التي تعمق الإختلاف أو تستدعيه، ولعل أحد أهم الانقسامات السياسية المحتملة هو الانقسام بين ” عَلمانيين ” و”اسلاميين” وأعلم أن كثيرًا من النخب السورية تميل للتشدد في تضمين الدستور ماينص على عَلمانية الدولة صراحة، وثمة احتمال كبير في معارضة ذلك لدى قطاعات واسعة من الجمهور فأرى أن من الأفضل أن نكون مستعدين للتضحية بالمصطلح مع الاحتفاظ بالمضمون لتجنب منح المتشددين هنا أو هناك السلاح الذي يبحثون عنه لإثارة الانقسام ودفع المجتمع باتجاه التعصب.
ثالثًا: ورد في وثيقة التوافقات عبارة تنص على ” منع الأحزاب الدينية ” فهل ستكون علمانيتنا أشد علمانية من الأتاتوركية حين قبلت بعد تردد الترخيص لعدة أحزاب ذات طابع إسلامي منها حزب الفضيلة وحزب الرفاه وحزب العدالة والتنمية. يقول الياس مرقص وهو من أهم المفكرين الماركسيين العرب كما ورد في كتاب حوارات غير منشورة بالنص: ” ” في المجتمع الديمقراطي الحديث والمعاصر، رأسماليًا كان أم اشتراكيًا أم غير ذلك، لابد من أن يكون فيه أحزاب متعددة وتيارات متعددة، ولابد من أن يكون فيه حزب ديني ولكن ديمقراطي، وحزب قومي عربي ولكن ديمقراطي، وحزب سوري قومي لكن ديمقراطي، وحزب ليبرالي ولكن ديمقراطي، وحزب شيوعي ديمقراطي، واشتراكي ديمقراطي. “.
المهم أن يكون دستور الحزب ينص صراحة على الخضوع لمبدأ الديمقراطية ونبذ العنف والخضوع للدستور، أما وضع عبارة تعني شطب الإسلام السياسي كله ديمقراطيًا أم غير ديمقراطي فهو خطأ لايمكن قبوله.
——————————-
حول وثيقة التوافقات الوطنية –2/ معقل زهور عدي
في البدء أستعيد ماكتبته سابقًا من أن هناك جهدًا متميزًا في إنتاج وثيقة التوافقات التي عمل عليها مركز حرمون للدراسات بطريقة تتصف بالحرفية والشمول ومحاولة إشراك 186 شخصية
ثقافية وسياسية بصياغتها عبر سلسلة من الحوارات الجادة . ومن خلال تلك الوثيقة تم تقديم رؤية متكاملة للدستور السوري المقترح للمرحلة مابعد النظام السياسي السوري . في النقاشات التي أعقبت تقديم الوثيقة والتي ساهمت بتنظيمها ونشرها ندوة وطن , اتضح إلى حد معقول هدف الوثيقة وهو تقديم بديل شبه جاهز للدستور السوري على أمل أن تتسع دائرة التوافق حول ذلك البديل في أوساط النخب السورية في انتظار رافعة غير محددة تتبنى ذلك البديل . من حق أي مواطن سوري في هذه المرحلة تقديم تصوره للدستور , ومن حق أي مؤسسة وطنية للدراسات أن تقوم بذلك , لا بل إن الواجب الوطني يتطلب من جميع القادرين على المساهمة في إنتاج الدستور لسورية الجديدة ( الجمهورية الثانية ) المبادرة لتقديم تصوراتهم وأفكارهم بالطريقة التي تناسبهم . وقد أحسن مركز حرمون بفتح الحوار في المرحلة الأولى قبل تقديم وثيقة التوافقات وبعد ذلك , كما أحسن بتأكيده أن الوثيقة مفتوحة للتطوير والتعديل وليست نصا مكتملا لايقبل النقاش والتعديل . لكن المشكلة أنه يقدم وثيقة التوافقات وبصورة أدق مشروع الدستور السوري في غير وقته . وقد أظهرت النقاشات أن مركز حرمون لايكتفي بطرح الوثيقة برسم المستقبل السوري لما بعد المرحلة الانتقالية , لكنه يطرحها لتكون وثيقة توافقات وطنية تتضمن مشروع الدستور بالضبط من أجل المرحلة الانتقالية وكافتتاح لتلك المرحلة . وقد ظهر ذلك بوضوح في جولة الحوار الأولى حين برر الأستاذ نادر جبلي من مركز حرمون ضرورة وضع فقرة تحت مسمى ضمانات فوق دستورية كجزء من وثيقة الدستور بالقول إن ذلك ضروري لخلق الثقة بين شتى مكونات المجتمع السوري لاستعادة لحمته ويعني ذلك بالطبع أن المسألة المطروحة أمامنا هي كيف نقنع جميع مكونات المجتمع السوري باستعادة سورية الموحدة كتمهيد أولي لايمكن أن يكون مكانه سوى المرحلة الانتقالية . إذن فالمخطط الزمني الافتراضي للوثيقة هو توسيع التوافق حولها ثم اعتمادها مع بعض التعديلات من قبل جهات غير محددة عشية التغيير المرتقب , ثم طرحها كوثيقة توافقات وطنية تتضمن مشروع الدستور السوري مع الاضافات والشروح الضرورية . والشيء الحسن في ماسبق أنها تطرح كوثيقة منافسة للجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها المفوض الأممي في 23 أيلول عام 2019 ولم تتمكن حتى الآن وبعد أربع سنوات من أي إنجاز هام على صعيد هدفها المعلن وهوتقديم دستور لسورية الجديدة . وتظهر وثيقة مركز حرمون أن بإمكان السوريين أن يقوموا بمثل ذلك الإنجاز على نحو أفضل بكثير خارج الاستبداد الرابض على قلوبهم والذي لايقبل التقدم خطوة واحدة على ذلك الطريق . لكن ماسبق لايعني أن الوثيقة جاءت في وقتها ولا يعني التغاضي عن الثغرات الكبيرة فيها . فما تحتاجه سورية اليوم ليس الدستور الدائم الذي يتضمن فقرات سميت فوق دستورية بمعنى عدم قابليتها للتعديل . لكن ما تحتاجه هو ميثاق وطني مؤقت للمرحلة الانتقالية التي ستؤمن عودة الحياة السياسية وإطلاق الحريات وتعافي المجتمع , وبعد ذلك سيتمكن المجتمع السوري من إنتاج ممثليه المنتخبين بموجب انتخابات حرة ليقوموا هم بمساعدة النخب السورية المثقفة والحقوقية بوضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية وفتح حوار علني وواسع حوله ومن ثم إقراره بموجب استفتاء عام . استباق تلك المرحلة والمبادرة لطرح مشروع الدستور الدائم بوحي من سيناريو الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية العتيدة من ممثلي النظام والممثلين الافتراضيين للمعارضة هو طرح في غير محله , وهو لكونه كذلك فهو يبدو وكأنه يريد استعجال الأمور بفرض بنود بعينها يمكن أن لاتكون محل قبول من غالبية الشعب السوري فيما لو نوقشت بأجواء الحرية نقاشا عاما مفتوحا وغير مقتصر على نخب ثقافية وسياسية محددة , أظهرت الثورة السورية أنها لم تتمكن من مواكبة الحركة الشعبية مما أفسح المجال للعسكرة ولتيارات الاسلام السياسي لمصادرة الحركة الشعبية وقيادتها وصولا إلى ما آلت إليه . ليس ذلك فقط , لكن بطرح أفكار مثل المبادىء فوق الدستورية منذ الآن فذلك لايعني تكبيل الارادة الشعبية فقط بدستور دائم يتم تمريره تحت ظلام مرحلة الاستبداد والتمزق والخوف الذي تعيشه سورية ولمرحلة طويلة ولكن لمرحلة غير محددة المدة الزمنية أيضا . ومثل تلك الفكرة لم تخطر حتى على بال لجنتنا الدستورية العتيدة ولا على بال الراعي الأممي ومن خلفه من القوى الدولية . المشكلة إذن ليست في تقديم مشروع دستور لسورية وهو حق وواجب على كل وطني غيور . ولا في التوقف عند فكرة هنا وفكرة هناك . المشكلة أن وثيقة التوافقات ولنقل بصورة أكثر دقة مشروع الدستور السوري الدائم – وفوق الدائم – يتم طرحها ليس من أجل المرحلة مابعد الانتقالية , ولكن كمشروع شبه جاهز على الرف مع وضع بعض اللمسات التي تعطيه رائحة التوافق الوطني ( توقيع 186 ناشط سياسي ومثقف وجولات الحوار ) برسم التغيير القادم بل وكفاتحة لذلك التغيير . سوف نقدر لمركز حرمون أن يتقدم بدلا عن ذلك بمشروع ميثاق وطني لمرحلة التعافي , ويبين صراحة وبوضوح أن مشروع الدستور الذي قدمه ليس لمرحلة التعافي وما بعدها بخطوة استباقية ولكنه مجرد تصور يضاف إلى جهود سوريين قبله لما ينبغي أن يكون عليه الدستور السوري الدائم , وأن مشروع الدستور السوري الدائم لايمكن طرحه لاعتماده سوى بعد مرحلة التعافي , ولايمكن تقديمه جاهزا للتصويت عليه سوى عند توفر ممثلين حقيقيين منتخبين من قبل الشعب بصورة ديمقراطية حرة .
————————–
وثيقة “توافقات وطنية” أم صك انتداب جديد بغلاف مزيف
نشر د. حسين مرهج العماش* في حسابه بالفيس بوك بوستاً بتاريخ 4 / 5 / 2023، معقباً على ما يسمى بـ”وثيقة توافقات وطنية” الصادرة عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وذلك تحت عنوان : “وثيقة توافقات وطنية ام صك انتداب جديد بغلاف مزيف”.
فيما يلي نص البوست ننشره حرفياً كما رصده موقع “سوريتنا” :
” وثيقة توافقات وطنية ام صك انتداب جديد بغلاف مزيف
(عن الوثيقة الصادرة عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 27 نيسان/ أبريل 2023)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الوثيقة الصادرة عن مركز حرمون بعنوان “مشروع وثيقة توافقات وطنية” عن مستقبل سورية هي وثيقة مرفوضة جملة وتفصيلا. وأصبح الحديث عن المستقبل في هذا الظرف سابقا لأوانه ويحمل معاني الهزيمة وليس معاني الحكمة. وما نقوله، أنه حتى لو كان العسل صافيا (اي الوثيقة) فوجود نقطة سم واحدة فيه كافيه لرميه بعيدا. ولهذا نقول للقائمين على المشروع ان يتكرموا علينا ويسحبوه ويلغوه نهائيا، لأنه في اقله هو إهانة جديدة للعرب المسلمين في سورية.
والوثيقة من الشروط المذكورة فيها ومن لغة المراوغة التي كتبت بها تبدو كأنها صك انتداب جديد مغلف زيفا بأسماء سورية. وهي عمليا تشرعن نتائج حرب نظام الأسد على الشعب العربي المسلم، ولكن بأيد بعيدة عنه هذه المرة، كما يبدو. نعم مشروع الوثيقة هذا ليس أكثر من تقية اسدية معتادة. فهذا المشروع لا يحلم الأسد بأحلى منه حتى ولو كتبته مخابراته في اقبيتها العتيدة.
فنظام الأسد الملتحف بالعباءة الوطنية المزيفة بقي أكثر من 50 عاما يراوغ ولا يجرؤ على الإفصاح عن ممارساته القمعية والطائفية البشعة عن شكل السلطة التي يريدها، حتى تطوع جهابذة مركز حرمون ليتحفونا علنا بما يشبه ما كان مخبوءا في دهاليز الدولة الاسدية، بكل صفاتها:
فهذه الوثيقة فيها عيوب جسيمة لا يمكن تسميتها بالوطنية التي نعرفها، حتى لو تطهرت سبعة مرات اولها بالتراب، لأنها:
1- تتنكر لمبادئ الديمقراطية والحرية للسوريين بأن تدعو لوضع مبادئ فوق الدستورية (حق الفيتو) لجماعات سورية عكس مبدأ الديمقراطية الحقة في كل العالم ليستمر النظام وحلفاؤه بحكم سورية، بل وكأن فرنسا لاتزال هنا.
2- تتنكر الوثيقة لعروبة سورية وتتنكر للأكثرية التي هي العرب السنة، وتراوغ بتعريف الهوية بكلمات غير مفهومة مأخوذة من قاموس الماركسية والطائفية لتخفي هدفا سريا.
3- انها وثيقة تتجاهل عمدا واقع وحق ملايين الضحايا اللاجئين والنازحين من العرب السنة حصرا، وتنسى وجودهم وحقهم، و”كأنه ما صار شيء في سورية”!
4- ان الوثيقة تتجاهل أيضا أسباب ثورة السوريين على النظام الاسدي الطائفي وتساوي جرائمه الفادحة ببعض ممارسات الثائرين، والتي هي نقطة ببحر جرائم النظام. فكيف تمت مساواة الضحية بالجلاد؟
5- ان الوثيقة تتبنى وتفرض علمانية غريبة، ضد الاسلام قصدا، لا يعرف مضمون هذه العلمانية حتى من كتبها سوى انها تسعى للتضييق على الإسلام، ولا تحترم معتقدات وثقافة الناس.
6- تتبنى الوثيقة طروحات تقسيم البلد والناس بصورة مواربة بفرض مطالب عرقية: مثل اللامركزية الموسعة للحكم، وفرض لغة رسمية أخرى للدولة مع العربية، و… وبكلمة أخرى ستكون سورية حسب وثيقتهم بلدا لا طعم له ولا لون ولا رائحة، احتراما لمشاعر الأقليات وسحقا لمشاعر الأغلبية العربية السنية. بئس ذلك المشروع.
هذه بعض أهم الرذائل الموجودة في هذه الوثيقة الغريبة. وهي كافية لتكون سببا للرفض القاطع التام لها واستنكارها وضرورة سحبها من التداول حفاظا على ما تبقى من احترام لبعض الأسماء الواردة في هذه الوثيقة.
أيها الاخوة المثقفون “الثوريون السوريون “:
أ- هنا تتكلمون في هذه الوثيقة عن مستقبل أنتم ترسمونه، ويبدو مضمونه كأنه من وحي مشاعر النظام، وتنسون ان جريمته لا تزال قائمة ومستمرة. فمن انتخبكم لتقرروا مستقبل هذا الشعب ومن فوضكم للتتحدثوا باسمه هكذا لتساعدوا الظالم على ظلمه؟
ب- كفى استهتارا، واحترموا تضحيات السوريين وثورتهم، واتقوا الله في وطنكم وأبناء قومكم واهلكم. الأولوية هي انقاذهم اليوم من قهر نظام الأسد، واطفاء حريق البلد بإسقاط نظام الأسد وليس فقط شخص الأسد بأسرع ما يمكن لأنه كلما طال الزمن ترسخت سلطة الشر أكثر.
ج- أنتم عشتم أو عايشتم المصيبة السورية المستمرة، وعشتم وتعايشون اليوم مدى الحقد داخل سورية، ومدى العنصرية والاحتقار تجاه اللاجئين بكل وقاحة وقلة حياء من كل حدب وصوب. حتى الاقربون، ممن يسمون بملوك وزعماء العرب، قد باعوا دم ملايين الضحايا بدون ثمن في سوق مصالحهم. فكيف لكم ان تقفزوا فوق هذا وتخلطوا الأولويات لدرجة تعمق المأساة بدلا من الخلاص منها. اخرجوا من شرنقتكم (التي صنعتموها بأنفسكم) واندمجوا مع مطالب ومآسي أبناء وطنكم. فهم درعكم منذ الأزل.
د- ثم بعد ذلك سنترك للسوريين كلهم ووحدهم، بدون وصاية من أحد، ان يقرروا مصير بلدهم وشكل حكومتهم بحرية وديمقراطية حقيقية. فلم ينتخبكم أحد ولم يكلفكم احد.
فسورية لن تكون الا دولة حرة عربية وديمقراطية لكل أهلها وبدون شروط مسبقة، مهما كانت. وان لم تكن كذلك فلتذهب الى الجحيم. لقد انتهى زمن التكاذب الوطني وليعرف كل شخص حقه وحجمه.
د. حسين مرهج العماش
2 أيار 2023″
*حسين مرهج العماش : خبير اقتصادي دولي ، رئيس هيئة مكافحة البطالة الأسبق
————————————–
وجهة نظر : حول التوافقات الوطنية/ زهير سالم
وجهة نظر :
حول التوافقات الوطنية
زهير سالم*
ووصلتني وثيقة، محبوكة حول التوافقات الوطنية، زج بها مركز حرمون مشكورا في الفضاء الوطني السوري، إن شئتم وصفتموه بالراكد وإن شئتم بالمضطرب، حتى يفقد ماؤه صفاءه، ويختلط به حديث القرايا بحديث السرايا..
وطلب مني بعض من ألوذ بهم أن أقول، على قلة بضاعة، وضياع في سوق الباعة…
والتوافقات الوطنية مطلب.ومطلب مهم. ولاسيما في اللحظات التاريخية الصعبة التي آل إليها أمر السوريين وثورتهم بعد اثني عشر عاما من التضحيات والدماء.
وأهم ما أتوقعه أو نتوقعه من التوافقات الوطنية في اللحظات التاريخية الصعبة، انها تحشرنا جميعا في موقف وطني جامع، في مواجهة “الظالم المستبد حبيب الفناء عدو الحياة”
واأنها توحدنا جميعا في أفق اللحظة، على الهدف المرحلي الجامع أن يكون لنا جميعا وطن للعدل والسواء. وأن يقوم فيه الناس كل الناس بالقسط، سواء وعدل وبر وقسط لا وكس ولا شطط..
إذا دعونا إلى راية تجمع موقفنا الوطني، فمن التفصيل المبعثر أن نناقش لونها وطولها وعرضها والسطر المخطوط عليها. هذه راية للجميع بيضاء ناصعة لا شية فيها.
وهكذا يمكن ان نجتمع، وأي عملية استباقية للاستئثار بموقع على الطاولة الوطنية، ستكون محاولة: مكشوفة، ومبعثرة مفرقة، وبالتالي مصادرة للمطلوب الوطني.
و تجسير الطامات على القنطرة الوطنية، يهدها.
وأفكار مثل مواد دستورية ضامنة أو فوقية، مصادرة للخيار الديمقراطي، الذي يشكل الأساس لأي بناء وطني جامع.
وكما نخاطب جمهور الشباب المسلم: لاتخافوا من الديمقراطية فالديمقراطية في مجتمعاتنا لا تأتي إلا بخير، يجب ان نخاطب الفئات الأخرى، لا تشترطوا على الديمقراطية، فالاشتراط على الديمقراطية يلغيها، ويحيلكم إلى نقيضها. ثقوا بالعقل الجمعي، لشعبكم فقد كان فيه دائما الكثير الطيب الحكيم.
يردون علي: تقرر ذلك من موضع المتكئ على أريكته الوثيرة، ولكن أليس هكذا هي طبيعة الأمور.
وسألني أحدهم يوما، وهو يخال انني حاصل على الجنسية البريطانية!! يا أستاذ زهير كما أنت في بريطانيا!! قلت له أنا في بريطانيا لو رفعت علم بريطانيا، فسأرفع علما عليه صليب!! وأنا في لندن لو رفعت علم انجلترا سأرفع علما عليه صليب أصرح وأوضح، لقوم يعقلون.
الأقلية الوطنية هي تلك الفئة المجتمعية التي ترى حياتها في الماء الذي تسبح فيه، وليس تناقضها الأول معه، لقد أساء لليهود حول العالم اعتبارهم لأنفسهم كانتونا أول تناقضاته وأقرب تناقضاته مع المجتمع الذي يعيشون فيه، لا تكرروا التجارب فلن تنجح.
إن التحدي الأخطر أمام الأقليات الوطنية حتى تكون وطنية، أن تتجاوز تناقضاتها مع محيطها، وأن تجعل تناقضها الأول في مرحلتنا التي نعيش مع “الظالم المستبد” وفيما يلي من مراحل مع مع مشروعات البناء والانماء.
والمحيط العام في مجتمعنا قابل..
ولكن كم كان في مجتمعاتنا مثل فارس الخوري ورشيد سليم الخوري، وبدوي الجبل، وجول جمال، وميشيل كيلو، وحفظ الأسماء له دلالة..
بالمعاني التي تحاولها الوثيقة لا أظننا نلتقي. كتب منيف الرزاز الأمين العام الثاني لحزب البعث، عن تجربته المرة، كدارس أقول لم يكن الخلل كبيرا في مبادئ المبعث، ولكن كان في وصفة وصفها منيف الرزاز رحمه الله تعالى، حين سمى الحزب “حزب الطوائف” لم يكن منيف الرزاز إسلاميا، ولا من مدرسة ما تسمونه “الاسلام السياسي” ولكنه كان إنسانا مبصرا…
من حقكم أن تختاروا اللون الذي تحبون، وأن تلبسوا الثوب الذي تحبون، ولكن ليس من حقكم أن تنزعوا عن الأكثرية “لباسها” !! ففكروا في هذا جيدا.
تنكرون المرجعية الربانية تحت عناوين العلمانية، والليبرالية، كل هذا في عالم السياسة والفكر مفهوم – وقولي مفهوم لا يعني أنه عندي وعند جمهور كبير من السوريين مقبول، أما أن تستبدلوا المرجعية الربانية الاسلامية الشرعية التي تجري في عروق ملايين السوريين، بل الأكثرية الكاثرة منهم، وتشكل وجدانهم، بمواثيق دولية مختلطة وتسودوها على عقول الناس وقلوبهم، فهذا أمر عجيب، دين جديد، وشريعة جديدة، وأنتم الأساتذة والمعلمون والمستشرفون والسباقون، وتعلمون أن كثيرا من مفردات هذه المواثيق ظلت موضع أخذ ورد بين المجتمعات التي أقرتها، على تجاذب، بل وما زالت، ومن ذلك مثلا الحق في قتل النفس، المجمّل بالحق بالإجهاض!! والحقوق المبتذلة التي ما يزال يندد بها الأسوياء..في كل المجتمعات!!
(أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)
وأخيرا ومع تقديري لكل السوريين، عندي مطلب وطني صغير: عندما يتحدث أحدنا، فلا يغمض عينيه، بل ينظر إلى كل من حوله بعينين وعقل وقلب..واذا وقفت خطيبا في قوم جل ثيابهم البياض فمن قلة الحصافة ذم الثياب البيض. تكونون ديلوماسسيين مع كل الناس، وتستخفون بآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وأبنائكم وبناتكم!!
في الشعر العربي بيت جميل:
أتانا شفيق عارضا رمحه
إن بني عمك فيهم رماح
ففي أبناء وطنكم قوم مثلكم يقدّرون ويقدرون.
لندن: ٨ شوال/ ١٤٤٤
٢٨ / ٤/ ٢٠٢٣
____________
*مدير مركز الشرق العربي
—————————-
السوريون في متاهتهم.. الوجه المستتر في الحوار الدائر حول “وثيقة توافقات وطنية”/ بسام يوسف
مقدمة
قام مركز حرمون للدراسات المعاصرة بمحاولة، هدفها الأساسي، كما ورد في مقدمة مشروع “نحو وثيقة توافقات وطنية”، المساهمة في الخروج من حالة العجز التي أصابت الطيف السوري المعارض، بأفراده ومجموعاته وهيئاته، عبر إطلاق حوار وطني موسّع حول توافقات وطنية عامة، تم التوصل إليها بعد حوارات وندوات امتدت لما يزيد على سنة، وشارك فيها عدد كبير من السوريين، واعتمدت منهجية جديدة تختلف عن الآليات السابقة في انتاج الوثائق السورية أو الرؤى التي أنتجها السوريون بعد انفجار الثورة السورية.
تتلخص المنهجية الجديدة في الابتعاد عن الشكل التقليدي السائد، والمتلخص بقيام جهة سياسية ما بإصدار وثائق وأدبيات تمثّلها، وبالتالي فهي وثائق تمثل هذه الجهة أساسًا. لكن المقاربة الجديدة اختارت طريقة أخرى تمثلت بمشاركة عدد كبير من السوريين متعددي التوجهات والآراء والمدارس السياسية أو الفكرية وأكاديميين ومؤثرين لإنتاج هذه الوثائق. وبالتالي يمكن القول إن ما قام به مركز حرمون يفترض به أن يمثّل طيفًا سوريًّا أكبر بكثير ممّا تمثله وثائق أخرى.
ربما كان باستطاعة مركز حرمون أن يدرس معظم الوثائق الصادرة عن مختلف القوى والتجمعات السورية، وأن يستخلص التوافقات الأهم؛ لكن من الممكن أن تكون لهذه الطريقة مساوئ عدة، لعلّ أهمها أن قسمًا كبيرًا من الوثائق قد أُنجز في ظلّ ظروف مختلفة عن الظروف الراهنة وعمّا وصلت إليه القضية السورية اليوم، وأن الوثائق المنتجة سابقًا لا تعكس بالضرورة حقيقة المجموعة التي أنتجتها؛ فغالبًا ما تُنتج الوثائق بالتوافق أو بإملاء أطراف قد تكون الأقوى، داخل هذا التجمع أو ذاك. هذه الثغرات وغيرها استطاعت وثيقة مركز حرمون أن تتلافاها، عندما دعت أشخاصًا بصفتهم الشخصية، وفتحت حوارًا بين أشخاص مختلفين في الرؤى وفي المرجعيات الثقافية أو السياسية، ويمثلون ما أمكن تنوّع الطيف السوري؛ وهذه نقطة تحسب لمركز حرمون.
نقطة أخرى أيضًا تُحسَب للمركز، وهي طريقة استخلاص نتائج أو توافقات 26 ندوة، شارك فيها 186 شخصية سورية، بعناوين مختلفة، مع ما يعنيه هذا من تقاطعات بين عدة محاور، وما تحتاجه هذه التقاطعات من جهد لاستخلاص التوافقات الأساسية فيها، ومن ثم صياغتها في وثيقةٍ تعكس وجهات النظر المطروحة قدر الإمكان. والأهم من هذا هو أن من قاموا باستخلاص نتائج الحوار كانوا محايدين، إلى حد كبير، إزاء الآراء التي بين أيديهم، رغم أنهم يختلفون مع أفكار عديدة وردت في وثيقة المشروع؛ وهذا ما قد تفتقده الوثائق الأخرى.
بعد الانتهاء من صياغة وثيقة “نحو توافقات وطنية”، قام المركز بإطلاق الوثيقة وطرحها للنقاش العام. وقد تابعتُ معظم الندوات التي ناقشتْ هذه الوثيقة، إن لم يكن كلّها. ما أريد الكتابة عنه ليس محتوى الوثيقة، (فأنا من المتبنين لما جاء فيها، وأعرف أن كتابات كثيرة ستركز حول محتواها، وهي متاحة لمن يريد، وكذلك معظم الندوات التي أجريت يمكن الحصول على تسجيل لها)، إنما أريد الكتابة عن منهجية الحوار الذي أعقب إطلاق الوثيقة، وكيفية التعاطي معها؛ وهذا ما أراه أمرًا بالغ الأهمية. فليس المهم أن ننتج وثائق بليغة ومحكمة، إنما المهم هو ماذا تفعله هذه الوثائق، وكيف يمكن لها أن تؤسس لفعل سياسي ما، أو تعزز من فهم أو رؤية يحتاج إليها السوريون في لحظتهم الراهنة أو في المستقبل المنظور لسورية.
حول عقم الحوارات السورية
أتمنى أن أكون متجنّيًا ومخطئًا، عندما أقول إن السمة العامة الأساسية، في كلّ الحوارات السورية التي أعقبت ولادة الثورة السورية، تتلخص باللاجدوى أو العقم، وذلك ليس على صعيد طرح الأفكار العامة والتصور النظري للمستقبل أو رسم الحلول المتخيلة قياسًا إلى هذه التجارب والثقافات أو تلك، بل على صعيد فعل هذه الحوارات في السوريين ومدى مساهمتها في تقارب أفكارهم أو توافقها. غالبًا ما يمكن وصف الحوارات السورية بأنها معارك مثاقفة محتدمة لا تبحث عن حاجة اللحظة السورية، ولا تبحث في عمق الخصوصية السورية وتفاصيل الظرف السوري وسيرورة متغيراته وتبدّل القوى الفاعلة فيه. فالمفردات والمصطلحات التي اختلف عليها السوريون منذ عام 2011 لا تزال هي نفسها، والحوارات التي جرت في عامي 2011 و2012 لا تختلف كثيرًا عمّا يجري بعد أكثر من عشر سنوات، بل لعلّها متطابقة معه في قسمها الأكبر، فالسوريون لا يتحاورون من أجل توسيع وتعميق رؤيتهم واختيار المقاربات الأكثر نجاعة، إنما يتحاورون كي يُثبتوا صحة رؤيتهم وخطأ من يخالفها!
أكثر ما يصف الحوار السوري اليوم هو ما يُسمّى “الجدل البيزنطي Byzantine discussion “؛ ففي القرن الخامس عشر الميلادي، عندما حاصر جنود السلطان العثماني محمد الثاني (محمد الفاتح) مدينة “القسطنطينية”، وفي الوقت الذي كان مصير الإمبراطورية بأكملها مهددًا، كان مجلس شيوخ المدينة منشغلًا بالنقاش حول أمور دينية ولاهوتية لا طائل منها، مثل جنس الملائكة (هل هم ذكور أم إناث). لم تنته مناقشة جنس الملائكة حتى هذه اللحظة، لكن الجنود العثمانيين اقتحموا أسوار بيزنطة في ذلك الحين.
أهم صفات الحوار السوري
غالبًا ما يذهب السوريون إلى حواراتهم مدجّجين بمواقف مسبقة، تحددها معايير لا علاقة لها بالحوار، ولا تخدمه، بل تفخخه في أغلب الحالات. والمعيار الأساسي الذي يعتمده معظم السوريين هو أسماء المشاركين، أو الجهة التي أصدرت الوثيقة، وليس محتوى الوثيقة. لا أعتبر هنا أن الجهة المصدرة لوثيقة ما، أو الأسماء المشاركة بلا أهمية، لكن الأهمّية الأساس تكمن في المحتوى، هذه المواقف المسبقة لا تشمل الحوارات فقط، بل تشمل معظم العمل الجمعي السوري، سواء أكان سياسيًا أم ثقافيًا أم مدنيًا أم حتى عسكريًا.
غالبًا ما يتخذ المتحاورون هذه العصبية أو تلك مرجعًا لهم، عصبية متولدة عن “هويات” ثقافية أو سياسية أو دينية أو مذهبية أو طائفية وربما مناطقية و..و.. الخ. هذه العصبيّات لا يمكنها أن تكون محايدة، والاختلاف برأيها ليس مشروعًا، ويجب فهمه وتفهّمه وتبنّيه، إن كان صائبًا، بل هو في رأيها تحدٍّ وتهديدٌ يجب التصدي له.
غياب وعي ضرورة تحديد الأولويات كمقدّمة لأيّ فعل، وضرورة إعادة ترتيبها ودرجة أهميتها وفق متطلبات كل مرحلة. فالقضايا التي ليس لها حضور مهمّ اليوم -فضلًا عن كونها مرهونة بشروط أخرى مستقبلية- يمكن أن تنسف اتفاقًا كاملًا حول قضايا راهنة ملحّة. وتجارب السوريين متخمة بأمثلة كثيرة عن “حوارات بيزنطية ” أفشلت مشاريع كثيرة، ولا تزال.
غالبًا ما يذهب السوريون إلى البحث عن التوافقات الكاملة فقط، أو عن التطابق التام. ويكفي أن يختلف المتحاورون في خمسة بالمئة من القضايا المطروحة، كي ينسفوا الـ 95% المتفق عليها. هنا أيضًا لدى السوريين أمثلة كثيرة على عبارات أو صياغات لا أهمية راهنة لها، فجّرت لقاءات أو توافقات كثيرة، كالاختلاف حول الجمهورية السورية أو الجمهورية العربية السورية، مثلًا.
ربما يتسبّب غياب القدرة على الفعل، وتلمّس نتائجه على الأرض، في تسيد هذا النمط من الحوار. فالشرائح التي تخوض هذه الحوارات هي، في معظمها، معزولة وعاجزة؛ ولهذا تستغرق في نقاش المفترض أو المتخيل. ففي غياب القدرة على الفعل، تغيب أهمية ترتيب الأولويات، فتصبح الحوارات نظرية، ويغلب عليها التثاقف والمماحكة.
انعكس الغياب الطويل للحياة السياسية والثقافية الحقيقية في سورية على علاقة النخب السورية بأساسيات الثقافة والسياسة والفكر، وخصوصًا في علاقة الثقافة والسياسة بالواقع. ولهذا يغلب في حوارات السوريين استحضار ثقافات مجتمعات أخرى وتجاربها السياسية، وهذا ما يؤدي إلى ضبابية الأفكار الأساسية التي لا بدّ من اتضاحها كي يتخذ الحوار دروبه المنطقية. بعبارة أخرى: إن غياب المحددات المعيارية لمجتمعٍ ما يؤدي إلى تبعثر الحوار وتغييب ركائزه الأهم. ربما كانت المرحلة التي نعيشها الآن (منذ بداية الثورة السورية) هي الفترة الأفضل لاستعادة النخب السورية لعلاقتها بالواقع، لكنها مع الأسف لم تستطع -بقسمها الأعم الأغلب- الخروج من معضلة اغترابها عن واقعها.
قياس الأفكار المطروحة على مقاييس خارجية كتجارب الشعوب الأخرى، وما تنتجه الثقافات الأخرى، وعدم محاولة قياسها على معطيات الواقع السوري. وهذا ما يتجلى بوضوح في نقاش النقاط الخلافية الأساسية التي تبرز في معظم حوارات السوريين، حول العلمانية وشكل الدولة، هل هي مركزية أم لامركزية، وحدود اللامركزية وشروطها…
هذه الصفات -وغيرها- مجتمعة تجعل من أي حوار سوري بلا أي جدوى، وبلا أي قدرة على التأسيس لفعل جمعي بالغ الضرورة والأهمية.
قد يلاحظ أيّ متابع وجود الصفات السابقة كلّها، بهذا الشكل أو ذاك، في الحوار الدائر اليوم حول وثيقة التوافقات الوطنية التي نناقشها في هذا المقال. وقد يبدو هذا الرأي متطرّفًا؛ لكن، حتى إذا جاز لنا تكثيف النقاط الأكثر إثارة للجدل كـ (علاقة الدين بالسياسة والدولة، والعلمانية، وشكل نظام الحكم، وشكل الدولة)، وهي ليست راهنة على الرغم من أهميتها، كما أن وضع تصور نهائي لها أو اختيار أنسبها مرهون بصيغة الحل السياسي، وبمدى استعادة السوريين لشرط حياة آمنة في ظل هذا الحل السياسي المنتظر، لكن هذا لا يعني عدم مقاربتها واستبيان آراء السوريين حولها -وهذا ما فعلته الوثيقة- لكن التخندق حول تفاصيلها الآن لن يكون مجديًا. وعلى الرغم من أن مركز حرمون أوضح بجلاء أن الوثيقة هي محاولة للدفع نحو إنتاج توافقات وطنية تمثل أوسع طيف سوري، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من الحوار الذي أطلقه المركز هو إغناء الوثيقة وتصويبها أو تعديلها بحيث تكون أكثر تعبيرًا عن آراء السوريين، وبالتالي أكثر قدرة على رفد التجمعات السياسية أو الجهات الثقافية أو البحثية في عملها.
كان من المهمّ أن يُطلق الحوار منذ البداية بهدف أساسي هو المساهمة في الإجابة عن أسئلة رئيسية تحتاجها الوثيقة من بينها: كيف يمكن تطوير هذه الوثيقة وإشراك أوسع عدد من السوريين فيها بغض النظر عن تصنيفاتهم؟ وكيف يمكن أن نستفيد منها كأفراد أو كتجمعات سياسية؟ وما هي الأولويات التي يتوجب على السوريين الاهتمام بها بغية التأسيس لمرحلة الانتقال السياسي؟ وما هي الأولويات في مرحلة الانتقال السياسي، وما بعد الانتقال السياسي؟.
إن زجّ الوثيقة في تفاصيل لا سبيل إلى الإجابة عنها الآن يعني إدخالها في جدل بيزنطي لا طائل منه. فلا يمكن مثلًا وضع تفاصيل العدالة الانتقالية التي تحتاجها سورية، لأن هذه التفاصيل مرهونة بالظرف الذي ستكون عليه سورية بعد الانتقال السياسي. إن ما تستطيعه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى، هو تبني العدالة الانتقالية كخطوة لا بد منها من أجل تعافي المجتمع السوري، لكنها بالتأكيد عاجزة عن وضع تفاصيل إجراءات هذه العدالة. هذا ما يصحّ أيضًا على شكل الدولة، وعلى نظام الحكم، وعلى نقاط كثيرة غيرها. بعبارة أخرى: إن الوثيقة مطالبة بوضع التصورات العامة للقضايا التي يحتاجها السوريون، كما يراها المشاركون في الحوارات. أمّا تجسيد هذه التصورات والعمل عليها، فهو من مهمة الأحزاب السياسية أو المشتغلين في السياسة.
من معظم الحوارات التي تابعتها (خلال المناقشات المتصلة بهذه الوثيقة، أو بغيرها)، يمكنني القول إن أكثر المحاور حرارة في هذه الحوارات هي ثلاثة محاور، وهي غالبًا ما تؤدي إلى تفجير معظم الحوارات: العلمانية، القضية الكردية، الطائفية. وسأجازف بالقول إنّ معظم الآراء حول هذه النقاط الساخنة تكون انعكاسًا لعصبية منفعلة أو لميل نحو شعبوية ما.
إن العقلانية في التعامل مع هذه “المحاور الساخنة” تتطلب الفهم الموضوعي المحايد لها أولًا، ومقاربتها بمسؤولية وفق متطلبات الراهن السوري بحياد وموضوعية ثانيًا، ولا سيما أن هذه المحاور الثلاثة هي الأكثر استغلالًا من جانب الشعبويين والطائفيين وغيرهم.
إن مشروع وثيقة “نحو توافقات وطنية” الذي أطلقه مركز حرمون يجب أن يحظى باهتمام النخب السورية، وباهتمام التجمعات والقوى السياسية، وأن يشكل خطوة مهمة في إطلاق حوار وطني واسع عقلاني مسؤول، قد يُفضي إلى صيغة فعل سياسي نحتاجه اليوم بإلحاح، لكننا سنحتاج إلى وثيقة أخرى ليست من مهمات مركز أبحاث، بل هي من مهمات القوى السياسية. إنها وثيقة مبادئ عامة، أو مدونة سلوك، تنظم علاقات هذه القوى، وتتم صياغتها على ضوء التوافقات الوطنية.
——————————
ملاحظات حول وثيقة توافقات وطنية/ فراس سعد
أولًا: اقتراح أسس فكرية:
في اعتقادي، إن المبادئ ما فوق دستورية يجب أن تعتمد على مبدأ الفرد السوري، وليس على الجماعة والجماعات السورية؛ فالمواطنة التي هي صفة الدولة (دولة المواطنة) تعود لفرد وليس لجماعة. والحقوق كلها تعود لأفراد وليس لجماعات، وإلا فسنقع في مطبّ التجربة اللبنانية والعراقية، وفي مطبّ تناقض مفاهيمي ما بين دولة المواطن المفترضة، وما بين ما اعتدنا على التفكير به ورسخ في لا وعينا. أقصد مجتمع ودولة الجماعات والطوائف، فالدولة هنا مهمّتها إرضاء الجماعات ومنع اشتباكها، والاشتباك من طبيعة الجماعات.
ومهما كان الدستور مثاليًا، فإنه ما دام يجعل الجماعات أساس الوطن، فسيصل إلى الطرق المسدودة والفساد والحروب الباردة أو الفعلية.
ثانيًا: شكل الدولة أم بنيتها ووظيفتها؟
أعتقد عند الدعوة إلى نقاش شكل الدولة لا يجب الركون إلى القوميين، سواء أكانوا قوميين عربًا أو قوميين كردًا أو سريانًا أو تركمانًا.. الخ، لأن الدولة التي يحدد شكلها الأيديولوجيون ستبقى دولة قلقة، من ناحية، ومن ناحية أخرى، ستكون دولة فاشلة حتمًا.
من الخطأ أصلًا نقاش شكل الدولة، الصحيح هو نقاش وظيفة الدولة ودورها، بعد ذلك نقاش بنية الدولة الضرورية لتقوم بدورها ووظيفتها المحددة. وبعد ذلك، يمكن نقاش شكل الدولة. (مثال على ذلك، اخترع شخص ما السيارة لتلبية حاجة السفر واختصار الزمن.. بدأت السيارة من فكرة تصوّر عام، ثم بدأ ببناء الآلة الجوهرية فيها الدولاب ثم المحرّك الذي يدفع الدواليب … وخلال عملية البناء، ظهر شكل السيارة أخيرًا).
أعتقد أن الدولة الناجحة، في كل مكان وزمان، هي التي تلبّي حاجات الإنسان الأساسية أولًا، ثم الكمالية لاحقًا، بأقلّ تكاليف وآلام وجهد ممكن.. وهذه الدولة يبنيها التكنوقراط والاختصاصيون والخبراء، وليس الأيديولوجيين والسياسيين، ولا سيما إن كانوا قوميين أو شيوعيين أو دينيين… الخ.
وظيفة الدولة هي التنظيم والإشراف والردع والرعاية، أي إقامة العدالة وحراسة الحياة، بما فيها من إنتاج ونموّ.
ثالثًا: بخصوص اللامركزية والعلمانية:
بالنسبة إلى اللامركزية: الدولة المركزية تحدد الخطوط العريضة للمناهج التربوية والمدرسية، بما لا يخترق مبدأ التعايش والحياة المشتركة ووحدة البلاد مجتمعًا ودولة. وهذا أمرٌ يتم حتى في ألمانيا اليوم، مثلًا.
نظام اللامركزية الإدارية مناسبٌ لسورية والعراق.. بل للعالم العربي ككل، ولكلّ بلدٍ يعاني آثار المركزية الشديدة والبيروقراطية..
بالنسبة إلى العلمانية: ما سميتموه (العلمانية اللينة) إضافة جديدة وخطوة إلى الأمام، في إشكالية علمانية ” العلمانيين السوريين”، ونظرتهم للواقع السوري.. فمن الواجب بالفعل تقديم بناء نظري وفكري لعلمانية جديدة، لا تعارض القيم الجوهرية للأديان والثقافات السورية، وفي نفس الوقت لا تعترض على القيم العالمية (حقوق الإنسان عدالة حرية فردية).
بالفعل، مسموعيات العلمانية غير جيدة في سورية والعالم العربي، لأن هناك أجهزة دعاية عربية ودولية ربطتها قصدًا بأشخاص نزقين مدّعين شبه جاهلين، يشتمون الإسلام ويعادون المجتمع باسم العلمانية. لذلك، أعتقد أن مصطلح الدولة العادلة، بالنسبة للسوريين، يدعو للطمأنينة أكثر بكثير من مصطلح الدولة العلمانية.
كم نسبة السوريين الذين يوافقون على العلمانية آخذين بعين الاعتبار الخلفية الدينية (والتدين عمومًا) لثلاثة أرباع السوريين، لا سيما بعد الثورة والحرب! أعتقد أن مجرد وجود كلمة علمانية في الوثيقة، وفي أي وثيقة، سيجعلها محلّ تشكيك ونفور من عامة السوريين.. لذلك لا بد من إيجاد بديل للكلمة، مع الإبقاء على مضامين ومحتويات العلمانية.
تعديل عبارة “تحمل مسؤولية العلويين”، فهي توحي بأن معظم العلويين مسؤولون عن ارتكابات النظام، بل عن النظام، باستثناء جماعة منهم. والجميع يعلم أن سورية، ومن ضمنها كل الجماعات السورية، مخطوفة من النظام ومن دول وأجهزة دولية، وأن النظام تم تركيبه وتعيينه وتوظيفه من قوى دولية وإقليمية وليس من العلويين..
لذلك، أقترح حذف هذه العبارة بالكامل، لأنها تُخفي نظرة نمطية روّجت لها قوى داخلية إسلامية وقوى معارضة فاشلة، لتحميل وزر فشلها على جماعة سورية مضطهدة وخائفة تاريخيًّا ومخطوفة، ولا تملك من أمرها شيئًا، مثل عموم السوريين.
رابعًا: اقتراحات عملية:
أقترح عقد حلقات للمشاريع المهمة مثل الطائفية، اللامركزية الإدارية، المقاصة والعدالة، كذلك عقد حلقةٍ للنقاش عن جوهر الدولة: هل هي المواطنة أم الجماعاتية. والإجابة عن السؤال الجوهري التالي الذي يحدد كل شيء: هل المجتمع السوري والدولة السورية المنشودان هما مجتمع ودولة الأفراد المواطنين الأحرار المستقلين؟ ام هما مجتمع ودولة الجماعات والطوائف؟
عقد حلقات مستمرة واجتماعات، عن كل موضوع ممّا سبق ذكره، لصياغة كل موضوع في مشروع عملي وتنفيذه.
التفكير في تكوين مجلس حكماء، يكون مرجعًا في المسائل الطارئة، ومنها المبادئ فوق الدستورية في المرحلة الأولى، يكون مقرّه خارج سورية لضمان حياديته وعدم تعرّضه للضغوط.
اقتراح برنامج لمكافحة العنصرية (الطائفية المناطقية الثقافية أو القومية) ورصد حملات الكراهية في وسائل إعلام الثورة والمعارضة. فخطورة وسائل الإعلام وكلّ منبر ينشر محتوًى سمعيًا بصريًا أنها تصنع رأيًا عامًا، بل عقلًا جمعيًا جديدًا للسوريين، ومع الأسف تشكّل العنصريات أساسًا ومكونًا أساسيًا له: العنصرية المذهبية، المناطقية، الثقافية، الدينية، الطائفية. ولذلك، أقترح تكوين مجلس أو حلقة عمل مفتوحة، لمتابعة ورصد وسائل إعلام المعارضة والمحتوى الإعلامي (يوتيوب..) ووسائط التواصل (فيسبوك …) تكون مهمّته جمع كلّ المواد العنصرية وغربلتها، وتحديد درجة خطورتها وأسباب انتشارها، واستهدافاتها، وفضح هذه المنابر، وعزلها عن مجتمع الثورة، ورفع دعاوى قضائية بحق القائمين عليها، في حال ثبات نهجها العنصري.
العجز والفعل والفاعلين:
الرد على العجز يكون بالتخطيط والفعل، وليس بالتخطيط فقط عبر إنتاج الوثائق، مهما كانت هذه الوثائق مثالية وكاملة.
لدينا مشكلة جوهرية تتعلق بـ “الفاعلين”، فنحن نتوهم أننا نقوم بفعل، لمجرد أننا نمتلك الفاعلية في إنتاج وثائق، علمًا أن كثيرين منّا -المشاركين في المؤتمرات والورش لإعداد وثائق ومسودات سياسية وتشريعية لسورية المستقبل- لا يمتلك أدنى معرفة في أسس الحوار، فضلًا عن القدرة أو الرغبة في فكّ الاشتباك وتقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا، وذلك لأننا -معظمنا- لم نصل إلى مستوى قبول المختلفين فكريًا وسياسيًا، والمختلفين ثقافيًا وأيديولوجيًا.
وهناك مشكلة أخرى في فاعلين وفاعلات تتكرر أسماؤهم، في كل المؤتمرات والورش واللقاءات والندوات، يعتقدون أن وجودهم الفيزيائي أو الافتراضي هو بحد ذاته فعل مقاومة يُسقط النظام، وخطوة لانتصار الثورة، علمًا أن بعضهم ليس لديه ما يقدّمه فعليًّا أو أنه استنفد ما لديه، وبعضهم مجرد وجوده يعطي رسالة سلبية لجمهور المعارضة والثورة، والبعض الآخر يأتي لتخريب أي اجتماع ومنع أي إجماع، لأسباب شخصية أو غير ذلك ربّما.
وثمة كوابح داخلية تمنع نجاح أي مؤتمر وندوة وورشة يعلن أسماء الحضور فيها؛ لأن السوري إنسانٌ يشخصن كل شيء، في أي وثيقة أو محاضرة أو أي مشروع، يتساءل السوري أولًا عن هوية الشخص أو هوية من يقفون وراء المشروع، لذلك إن لم يكن الأشخاص أسوياء نزيهين، وعلماء أو خبراء في مجال ما، فلن يقبل السوريون أي شيء يقومون به أو يقدّمونه للعموم.
الخطوة التالية:
بالمجمل، هذه وثيقة جيدة، فيها إضافات، وتحتاج إلى مزيد من التعديل بما يناسب الحالة السورية الكارثية، الخشية أن توضع الوثيقة إلى جانب أخواتها السابقات، وهنا يفترض بنا أن نسأل: ما هي الخطوة التالية؟
وإذا لم نحاول فعل شيء لوضع بعض توصيات الوثيقة محلّ تنفيذ، فلن يكون لها فائدة عملية.
ختامًا، يبقى سؤال أخير: مَن سيضمن تطبيق هذه الوثيقة أو الدستور بعد الحرب؟ فألمانيا مثلًا لولا الدعم الأميركي الأوروبي لم تنهض.
مركز حرمون
————————————-
“توافقات سوريّة محكومة بالاجتراحات”.. مراجعة “مشروع وثيقة توافقات وطنية”/ صبيحة خليل
بداية، لا بدّ من القول إنّ الوثيقة تُعَدّ ورقة مهمّة للغاية، وذلك بسبب مهنيّة الورقة والتزامها المعايير العلمية للوصول إلى المخرجات والاستنتاجات على خلفية جلسات نقاش وحوار معمقين، وتنبع أهمية الورقة القصوى من حراجة المرحلة بالنسبة للشعب السوري الذي دخل في منعطف مصيري، قد ينتهي بتفكيك الدولة السورية على وقع التدخلات العسكرية والإقليمية والدولية. ما يعني إعادة إنتاج منظومة الاستبداد بكلّ مرتكزات القمع والطغيان، وترحيل مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية لعقود وربما لقرون مقبلة.
وعلى الرغم من أن الوثيقة تُعدّ نتاج سلسلة نقاشات وتقاطعات وتوافقات بين إرادات سوريّة ذات توجهات مختلفة، قد تكون بعضُها على خلاف، ومن مشارب مختلفة؛ فإنها لا تُخفي ميلها إلى إرضاء الإسلام السياسي. وقد ظهر هذا الأمر جليًا في أكثر من فقرة، ولا سيّما تلك المتعلقة بالدستور وشكل الدولة وهويتها؛ إذ لا يمكن التعويل على أي وثيقة، ما لم يتم التوافق فيها على ركائز المواطنة المتساوية، التي ترد في الوثيقة كالتالي: “لا تستوفي المواطنة المتساوية أركانها وشروطها إلا في دولة ديمقراطية من جانب، ومحايدة تجاه الأديان والمذاهب والمعتقدات من جانب آخر”. أي دولة الحقوق والواجبات التي تحكمها قوانين، وفق دستور عادل غير متحيّز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو أي اعتبار آخر.
فمن جهة، تورد الوثيقة في الصفحة 8 أن “الدولة السورية القادمة ستتبنى منظومة الحقوق والحريات الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، ومن جهة أخرى، تطالب باجتراح الحلول الملائمة لمشكلة تعارض بعض تلك الحقوق مع ثقافة المجتمع السائدة!! وتكمن خطورة هذا المجترح أولًا في الرغبة الانتقائية في تضمين منظومة الحقوق، التي يتفق المختصون/ات على أنها سلّة واحدة لا يمكن تجزئتها. وثانيًا في النيّة لتدوير ثقافة المجتمع التي تقف على النقيض من بعض الحقوق والحريات، والتي تنتهك بالدرجة الأولى -بحسب تجربتنا ومعرفتنا السابقة لهذه الثقافة- حقوق النساء وحقوق بعض مكونات التنوع السوري. وهنا يجب الإشارة إلى أنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول في تجاوز بعض العراقيل المشابهة التي تعترضنا، لكن بشرط ألا تكون تلك التجربة قائمة على الالتفاف والتذاكي على منظومة حقوق الإنسان، وذلك لأن هذه المنظومة هي، بالدرجة الأولى، وعاءٌ ونتاج إنساني، وتهدف إلى كبح جماح الهيمنة والتسلط وتمركز القوة بيد طغم حاكمة. وبطبيعة الحال، لا تقف شرعة حقوق الإنسان حائلًا أمام حرية المعتقدات، لكن العكس كثيرًا ما حصل عندما فرضت الأيديولوجيات العقائدية والدينية هيمنتها بقوة الحديد والنار. والتجربة السورية مريرة مع منظومة البعث الأمنية التي قمعت كل من اختلف معها سياسيًا، وفرضت العروبة شرطًا لازمًا للمواطنة، واحتكرت الدولة، وجرّمت العمل في الشأن العام. أما التنظيمات الدينية الراديكالية الإسلاموية، فقد فرضت هيمنتها على حيوات الناس، وكان للنساء تحديدًا نصيب مضاعف مما ارتكبته من الفظائع، بالإضافة إلى بعض المكونات الأكثر هشاشة كالأيزيديين على سبيل المثال، ولنا في تجارب (النصرة) و(داعش) إرثٌ ثقيلٌ من الجرائم، التي اتخذت الدين الإسلامي غطاء وأداة لصهر الآخر المختلف.
وهنا، لا بدّ من التنبيه إلى أنْ لا أحد يريد أن يحمّل وزر جرائم الفصائل الراديكالية لجميع المسلمين/ات، أو وزر جرائم النظام وحزب البعث لكلّ العرب أو الطائفة العلوية، لكن الاستمرار في المحاباة والتفضيل هو نوع من دق الأسافين في دولة المواطنة المتساوية قبل كل شيء، والتي ما تزال بعيدة في الأفق المنظور، إن بقيت الاشتراطات ذاتها بانتظار الاجتراحات.
وعلى سبيل الاجتراح، أودّ لفت الانتباه إلى ضرورة تضمين تجارب السوريين/ات الفارّين إلى أوروبا بعد الحرب، ويبلغ عددهم قرابة المليون، يتركز أغلبهم في ألمانيا، وهم من شرائح مجتمعية وطبقية متعددة، وفيهم قسمٌ لا بأس به ذو طبيعة محافظة، فما كان بالإمكان أن تجد هذه الفئة الملاذَ الآمنَ في أوروبا ذات الغالبية (المسيحية)، لولا قيم ومزايا الدول العلمانية ودولة المواطنة المتساوية بدون تمييز. واللافت أن الشريحة المتديّنة/ المحافظة، من خلال المتابعة والملاحظة، تبدي اندماجًا أفضل والتزامًا بالقوانين، مقارنة بالجاليات الأخرى الموجودة في تلك البلدان. وعلى ضوء تعقيدات القوانين، ولا سيما المتعلقة بقوانين حقوق الإنسان، ومن بينها طبيعة العلاقة مع النساء والأديان والخصوصيات الشخصية، فقد قطع اللاجئون/ات السوريين/ات شوطًا لافتًا للانتباه، بمسائل الاندماج وتعلّم اللغات وسوق العمل. المثال يعطينا فكرة قابلة للتطوير والنقاش حول تبديد المخاوف من ردة الفعل المجتمعية تجاه تقبّل المفاهيم الحقوقية، لا تطويعها بالضرورة على مقاسات الثقافات المجتمعية غير المحايدة، ولربما كانت نتائج تمثّل مفاهيم حقوق الإنسان والحريات أفضلَ مما هي عليه، لولا تدخّل الجمعيات الأهلية ذات الميول والتوجهات السلفية التي تنتمي غالبيتها إلى جاليات أخرى غير سورية، كانت في أوروبا قبل موجات اللجوء السوري.
بخصوص مفهوم العلمانية، نجد في الصفحة 16 الفقرة (ب) من الوثيقة ما يلي: “طرح خطاب علماني ذكي ومختلف ومتفهم للثقافة والبيئة، ويبتعد عن استفزاز المتديّنين”. أعتقد أن واحدة من المسلمات السياسية أن العلمانية أكثر قدرة على استيعاب التنوع الديني والإثني والعيش المشترك وإدارة التنوع، وهذا ما جاء في الوثيقة أيضًا. وذلك باعتبار مسألة الدين والمعتقد في الأدبيات العلمانية جزءًا من الحريات الشخصية، على عكس محاولات الأديان التي تفرض نسقًا محددًا ومضبوطًا من القوانين لتطويع وإرضاخ المجتمعات وإخضاعها لسلطتها الدينية. الأمر الآخر هو الاتهام المضمر للعلمانية، باستفزاز المتدينين! وهذه التهمة تعقّد مسألة التوافق، وتضع العلمانية في قفص الاتهام، وهذا ما يناقض روح النص، وهنا يحتاج الموضوع إلى إعادة تصويب. يرى كثير من السوريين/ات أن المؤسسة الدينية هي من تحتاج إلى تطوير أدواتها النقدية وآليات تفكيرها التي أنتجت الطوائف المتناحرة، وأقامت الدنيا ولم تقعدها منذ قرون، ولم تنتج حتى الآن أي تسوية مرضية بين الجماعات المنتمية إلى تلك الطوائف، سوى بعض الهدن المشوبة بالكراهية، فعلامَ نختزل المشكلة بالعلمانية واستفزاز المشاعر الدينية! فالمتديّنون/ات ليسوا طبقة متجانسة واحدة رافضة للعلمانية، وكما أن هناك فئة رافضة، هناك قسم لا بأس بهم لديهم القناعة أن العلمانية هي الحل الأمثل لتشميل حقوق الجميع، وهم ليسوا أقلية في المجتمع السوري. ثمة توصيفات أخرى لنفس المصطلح، في سياقات أخرى من الوثيقة، كسوء السمعة والفهم، وكأن الوثيقة تطالب السوريين/ات بتفصيل علمانية على مقاس الإسلام السياسي، لقطع المسافة الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، وما إن يصبحوا حكامًا حتى يرموا بهذه الأدوات التي لن يحتاجوها في فرض سلطتهم، وبذلك نكون قد بدّلنا قشرة الاستبداد دون بنيته!
في المنحى ذاته، يوجد شيء من التناقض بين التركيز على مفهوم الهوية الوطنية الجامعة، وربطها بالحضارة العربية والإسلامية تحديدًا، وهذا يُعيدنا إلى المربّع الأول. بدلًا من ربط الهوية الوطنية بإرادة السوريين/ات في الرغبة بالعيش المشترك، وفق المصالح الوطنية وضمن الجغرافية السورية بين مختلف المكونات، للعيش باستقرار وسلام ووئام، يعود التركيز على التفضيل وتمرير المحتوى ذي الطابع الإسلامي والعربي، بالاعتماد على الأكثرية العددية، دون الأخذ بعين الاعتبار القطع مع الهويات العابرة للحدود التي لن تبني هوية وطنية جامعة لا اليوم ولا في المستقبل. ولا أدري هنا ما الضير في أن تكون هويتنا الوطنية تستمد مناعتها من الإرث التاريخي السوري الثري، من حيث إنها جزء من الحضارة الإنسانية.
في ما يخص المسألة القومية، ولا سيّما الكردية، تشكك الوثيقة بالحيف والجور الذي طال الكرد، حيث ورد في الصفحة 17: “الاعتراف بأخطاء الماضي (في حال حصولها)”. والماضي المقصود هنا هو ماضي نظام مستبد نكّل بكل السوريين والسوريات، وكان للكرد خصوصية معيّنة من هذا الحيف والجور، فهل ثمة شكوك في ذلك؟! أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إجابة واضحة.
وهناك مسألة أخرى لا تقلّ خطورة عن المسائل السابقة، وردت في الصفحة 16، حول منظومة القوانين التي تحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي. علّمتنا تجربتنا مع الاستبداد أن الحظر ليس حلًا للمشاكل بالضرورة، وإنما هو ترحيل مؤقت للمشاكل ودفعها نحو الأسفل، لتقوم الجهات المقموعة، انطلاقًا من الإقصاء والتهميش، بتشكيل أجسام سرية باطنية تجتاح المجتمعات المحلية من الأسفل. فضلًا عن باقي المشاكل الأخرى الناجمة عن تدوير المظلوميات ونقلها إلى مستقبل سورية. الحلّ يكمن بإنشاء آليات رقابة وشفافية، تحظر خطاب الكراهية والتمييز على أي أساس كان، فالأحزاب المسيحية الديمقراطية منتشرة في حوالى 80 دولة من دول العالم، وثمة نماذج لا تشكل فيها المسيحية سوى اسمها، لأنها ملتزمة بقوانين الدولة العلمانية، وتنطبق عليها قوانين الأحزاب الأخرى دون تمييز، حتى إنها تقبل اللادينيين أعضاءً. وجهة النظر هذه نابعة من قناعتي أن حلول المستقبل يجب أن تتبنى السماح، ما لم يكن هناك خرق لمعايير الديمقراطية، ولا يوجد مبرر لحظر أي جماعة بمجرد الاسم مثلًا. كما لا يجوز طمر قضية ملتهبة بدون تعريضها للشمس، فنحن بالكاد مثلًا نعرف بعض قادات جماعات الإخوان، أين البقية؟ ألا يجب أن يظهروا إلى العلن، أم أن القانون سيواريهم في كواليس هم أكثر من يتقن اللعب فيها!
من ناحية أخرى، ورد في الصفحة 22 بعض المصطلحات، من قبيل “العدالة المناطقية”، وتنمية تمييزية مؤقتة، وأعتقد أن تلك المصطلحات غير موفّقة، بالرغم من أحقية الإجراءات. فمعروف أن العدالة الأفقية تفي بالغرض، من تشميل وتضمين جميع المناطق والأطراف والأقاليم، بدون التركيز بالضرورة على مراكز المدن الكبرى في عمليات التنمية. وعن “العدالة التمييزية المؤقتة”، أيضًا ثمّة مصطلح يصيب الهدف ذاته، وهو “تدبير إيجابي مؤقت”، لردم الفجوة الحاصلة نتيجة سياسات خاطئة، لتعويض النقص الحاصل وجبر الضرر.
ورد في الصفحة 24 من الوثيقة عبارة: “جعل التعليم إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الإعدادية”، في الحقيقة أن التعليم الأساسي إلزامي منذ عام 2002، بغض النظر عن كوارث التطبيق والمشاكل الكبيرة التي تهدد حاضر ومستقبل البلد.
أما موضوع اللامركزية الإدارية الموسعة، فيتبين -من خلال الشرح- أن حل مشكلة غياب الديمقراطية وتضمين التنوع وتحقيق التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال نظام لامركزي، وهو تمامًا يحمل في طياته مفهوم اللامركزية السياسية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إلى متى سنظل نحن السوريين/ات نهرب إلى الأمام، ونبدي خشيتنا من أي إشارة إلى “السياسة”؟! هل المطلوب أن نتماهى مع حقبة الاستبداد التي لم تجد في الشعب السوري أهلًا لممارسة السياسة؟ أنا هنا أطرح الأسئلة فحسب، بالرغم من أن المضمون في الوثيقة يشي بالحق السياسي، من خلال التدخلات المحلية في الانتخاب والتمثيل والقرارات الاقتصادية التنموية، فهل هو الخوف؟ أم أننا سنبقى على نهج السابقين؟ فيما يخص نظام الحكم، يرد في الوثيقة تفضيل الشكل المختلط نصف برلماني، وهذه تحتاج إلى وقفة حقيقية، ففي أماكن أخرى، تورد الوثيقة نصيحة بضرورة الابتعاد عن الخيارات العاطفية غير المدروسة! فهل النظام المختلط هو خيار مدروس حقًا! ما أعرفه شخصيًا أنه خيار بعض الدول.
يؤخذ على الوثيقة أنها تجنّبت الخوض المباشر في أي قضية تخصّ التمييز ضد النساء، سواء المجتمعي أو الثقافي أو القانوني، ولم تقدّم أي ضمانات أو توصيات حول حقوقهن، علمًا أن النساء، وتحديدًا النسويات منهن، يتعرضن لموجة كراهية شديدة في السنوات الأخيرة، وقائمة المشاركات تفيد بأنهن كنّ مشاركات في جلسات النقاش، فلماذا لم تُظهر الوثيقة أي إشارة لأصواتهن؟! في حين أن التجارب حول العالم تُثبت أن قضايا النساء يجب أن يفرد لها أبواب منفصلة، حتى وإن كان هناك منظومة حقوق عامة تخص الجميع، أي أنه لن تحصل النساء على حقوقهن بمجرد صياغة وثيقة حقوق عامة، بل يجب أن تُفرد أي وثيقة وطنية بنودًا خاصة تضمن المساواة بين النساء والرجال، بالكرامة والحقوق. ولهذا السبب وغيره، أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية (سيداو) لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة العنف ضد النساء، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة السلام والأمن.
ختامًا، هذه الملاحظات هي على قدر محبّة سورية التي نحلم بها معافاةً، ملكًا لكل أبنائها وبناتها، وليست موجهة إلى شخصكم الكريم في مركز حرمون، إنما ننتقد لنبني جسر العبور إلى المستقبل السوري الحرّ والديمقراطي التعددي.
مركز حرمون
——————————-
ملاحظات عامة حول مشروع وثيقة توافقات وطنية/ هدى أبو نبوت
قام مركز حرمون للدراسات المعاصرة مشكورًا بالعمل على رعاية مشروع “وثيقة توافقات وطنية”، الذي ساهم في إنجازه مجموعة واسعة من التيارات الفكرية والسياسية، وناقشت الوثيقة أهمّ القضايا الخلافية والجدلية التي ستواجهنا، السوريين والسوريات، لبناء دولة سورية الجديدة، وانطلاقًا من القناعة التامة بضرورة توسيع طيف المشاركة وتجسيدها كأهمّ فعل دالّ على المواطنة المتساوية المنشودة، كانت الملاحظات الآتية على الوثيقة، على أمل إغناء النقاش، وتقريب وجهات النظر، والوصول إلى الاتفاق المأمول الذي يضمن إنشاء أسس ثابتة لبناء دولة مدنيّة تُعلي قيم المواطنة والحريات.
انطلاقًا من جوهر المشروع القائم على السعي للاتفاق على وثيقة وطنية، أجد أن من الضرورة التوقف عند الخلفيات السياسية والمدنيّة والأيديولوجية للمشاركين والمشاركات في الحوار حول الوثيقة، والإجابة عن السؤال الأهم: هل تمثّل هذه العيّنة من الأسماء التي شاركت في هذا الحوار مختلف شرائح المجتمع، دينيًّا وسياسيًّا وقوميًّا وأيديولوجيًّا؟ وهل شاركت كلّ التيارات السورية المتباينة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في تناول المواضيع الحساسة التي أوردتها الوثيقة؟
من المفيد جدًّا فتح باب النقاش حول الوثيقة، وأرجو أن يؤدي هذا النقاش إلى النتيجة المرجوة منه بعد صياغة مبادئها.
بعد مراجعة الأسماء التي شاركت في الحوار، نلاحظ أن هناك أطرافًا كثيرة فاعلة في المجتمع السوري، وتملك وجهة نظر مختلفة تمامًا عما ورد بالوثيقة، لم تكن حاضرة، ولم تشارك رأيها، ولم يكن لها أيّ دور، وعلى الأغلب لا تتفق مع ما جاء، بما يخصّ -على سبيل المثال لا الحصر- شكل الدولة ونظام الحكم ومبادئ الدستور وما طرأ على هيكلية النسيج الاجتماعي السوري ببعده الطائفي والقومي، كما طرحت الوثيقة، (المسألة الطائفية والكردية).
ولكي يتبلور الجهد الكبير الذي قام به مركز حرمون للدراسات، نورد أهم التوصيات بهذا الخصوص:
عقد مزيد من المشاورات بشكل موسع، على أن تشمل كل التيارات المختلفة التي لا يمكن تجاوزها، فهي تعكس وجهة نظر شرائح كبيرة من المجتمع، لأنه من السهل التوافق بين المجموعات المتقاربة بوجهات النظر حول ما تم طرحه، في حين أن المعضلة الحقيقية التي ستواجهنا، السوريين والسوريات، في بناء سورية الجديدة، هي الحوار الواسع دون إقصاء، لأن غياب أي جهة سيكون عائقًا أمام تحقيق الهدف في المستقبل، لعدم جدوى تطبيق قواعد تتعارض مع الأغلبية.
بما يخصّ البنود التي جاءت بالوثيقة، كانت الملاحظات كالتالي:
جاء في الفقرة التي تتحدث عن القواعد الدستورية المحصنة التي تحتاجها سورية نقاط جوهرية مهمة، اتفق مع مجملها، ولكي نصل إلى الاتفاق على هذه القواعد، علينا الاعتراف بأن هناك طيفًا واسعًا من السوريين ما زالت هذه القواعد الدستورية التي وردت بالوثيقة مثارَ خلاف ورفض أو تحفظ عندهم، بسبب تباين التيارات السورية لرؤيتها لسورية الجديدة، وخصوصًا الأحزاب السياسية الدينية أو القومية، فضلًا عن الشرخ الاجتماعي الذي أصاب المجتمع السوري، وأظن أن من المبكر الاعتماد عليها، كصيغة جامعة، لأن التوافق يحتاج إلى حد أدنى من الثقة بين كل شرائح المجتمع، وهو بالوضع الراهن غير موجود، إضافة إلى أن إقناع كل الأطراف، بأن هذه الصيغة هي التي تؤسس لضمان الحريات وتحقيق المساواة وبناء الدولة على أسس المواطنة، يحتاج إلى جهدٍ يعيدنا إلى التوصية بضرورة عقد نقاشات مطولة بين المختلفين جذريًّا حول هذه النقاط، لا المتفقين بالحد الأدنى عليها.
ورد في آخر الفقرة (ب) عبارة غير واضحة، تسمح لحدوث التباس كبير… ما لمقصود بتكريس مبدأ دستوري يقضي بسمو الاتفاقات والمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية؟
من البديهي أن يكون هناك احترام والتزام صريح بتنفيذ كامل الاتفاقيات الدولية التي تقوم السلطة السياسية الحاكمة بالتصديق عليها، ولكن لماذا تسمو هذه الاتفاقات على التشريعات الوطنية التي يفترض أنها موضوعة بعناية لضمان حقوق المواطنين والمواطنات دون أي تمييز؟ ما الذي يضمن أن وجود إشارة بالدستور “تجعل مرتبة الاتفاقات والمعاهدات الدولية” بمنزلة محمية بالدستور أكثر مما يحمي تشريعاتنا الوطنية عدم المساس بالسيادة الوطنية؟ نتمنى تقديم شرح أو توضيح لهذه الفقرة، أو فتح باب النقاش الموسّع حولها.
ورد، في فقرة الحقوق والحريات في سورية الجديدة، مقترح مهمّ: (للتغلب على صعوبة توفيق قوانين الأحوال الشخصية مع الشرعة الدولية، يمكن إصدار قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية، إلى جانب تلك القوانين الخاصة بالطوائف والمذاهب، ويسري على جميع السوريين، وتترك للناس حرية اللجوء إليه إذا رغبوا بذلك)..
ولكن نعلم جميعنا أن هناك قوانين تمييزية كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي ضدّ فئات عديدة بالمجتمع، منها النساء، بقضايا كثيرة تتعلق بالزواج والطلاق والإرث والقوامة والولاية… الخ، وعندما نطرح فكرة قانون مدني يكفل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وآخر شرعي تابع للطوائف، سنجد أنفسنا في تناقض واضح مع مبادئ الدستور المتوقعة، التي تكفل جميع الحقوق لكل المواطنين والمواطنات بدون تمييز على أساس العرق واللون والجنس والدين والقومية، وهنا تظهر من جديد الحاجة الملحة، بالفترة اللاحقة، إلى حوار مجتمعي على مستوى رجال الدين والقانون، للنقاش فيما بينهم من جهة، ومع باقي فئات المجتمع الأخرى، على هذه التناقضات التي ربما تؤدي إلى توافقٍ ما يقلّص هذه الهوة ويجنبنا اللجوء إلى هذا الخيار. وكذلك كانت هناك إشارة في الفقرة (ب)، إضافة إلى وضع تصوّر قابل للتطبيق بإطلاق مبادرة لرعاية هذا الحوار يحاكي العمل على هذه الوثيقة، على سبيل المثال.
ووردت في فقرة معالجة الأزمة الطائفية هذه العبارة: السعي الدؤوب لتحقيق عدالة انتقالية في سورية، باعتبارها (الوسيلة الأكثر فعالية لسحب فتيل الأزمة الطائفية وإعادة السلم الأهلي). وهنا أقول: هناك دول عديدة خاضت تجارب شبيهة بسورية، وخلّفت شرخًا اجتماعيًا كبيرًا، لأسباب طائفية أو عرقية أو قومية، كالبوسنة ورَوندا، على سبيل المثال لا الحصر. وتجربة سورية ليست منفردة، لكنها تملك خصوصية لتجذّر البعد الطائفي بمكونات المجتمع والدولة أكثر من خمسين عامًا، إضافة إلى ما خلّفته سياسات الأسد الطائفية في قمع الثورة، ومحاولة تحوليها إلى حرب أهلية. وهناك أجيال جديدة نشأت بهذه البيئة السامة خلال السنوات الطويلة، ونحتاج إلى الاطلاع على تجارب كل الدول، في سبل تجاوز ما مرّوا به، ونحاول الابتعاد عن النسخ واللصق لتجارب لا تشبه مجتمعاتنا ومشاكله الحقيقية، بل الخروج برؤية من وحي التجارب الناجحة، مثل وضع خطط تتعلق بتحقيق العدالة وملاحقة الجناة وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، وعدم الاستهانة بتأثير هذه القواعد، لردم الهوة والتشجيع على التجاوز والمسامحة وفتح صفحة جديدة بالتدريج تساعد المجتمع في التعافي.
عند الإشارة إلى دور منظمات المجتمع الدولي في سورية الجديدة، أغفلت الوثيقة تحديًا كبيرًا تعانيه منظمات المجتمع المدني السورية الحالية التي تأسست بعد اندلاع الثورة حتى الآن، وإن كانت أشارت إليه الوثيقة بشكل مختصر وضبابي. وهو علاقة منظمات المجتمع المدني بالممول الأجنبي، وتنفيذ برامج كثيرة تكبّل حرية العاملين بمنظمات المجتمع المدني، وتقيد قدرتهم على العمل الحقيقي الذي يصبّ بصالح الدولة الوطنية التي نتطلع لها. ونحتاج إلى مراجعة شفافة لهيكلية المنظمات وآلية عملها والخطط التي تشرف عليها، والاستفادة من الخبرة الكبيرة التي اكتسبها العاملون والعاملات والمديرون والمؤسسون لهذه المنظمات، من دون إقصاء أو تهميش لأي مكون، لوضع رؤية استراتيجية وطنية تنفذ مشاريع وطنية بعيدة عن إملاءات المموّل التي تحدّ إلى درجة كبيرة من قدرة هذه المنظمات على التأثير في القطاعات العاملة فيها كافة، من الإغاثة إلى الشق التوعوي.
وهناك ضرورة ملحّة لإعادة النظر في خطط الإغاثة كأولوية، والانتقال إلى مرحلة التنمية الحقيقية التي تحتاج إليها المرحلة القادمة، وهناك تجارب دولية مهمة بدمج قطاع الإغاثة بالتنمية، بحيث نتخلص من اعتماد معظم شرائح المجتمع على السلة الإغاثية، والتدرج لإحياء الشخصية السورية المنتجة من جديد
في الفقرة الخاصة بالتعليم في سورية الجديدة، نلاحظ أن الوثيقة وضعَت أسسًا وقواعد للتعليم في مرحلة الاستقرار، لا قي مرحلة الأزمة، وأظن أن ملف التعليم يجب أن ينظر إليه كحقيبة أزمة، تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق، لردم مخلفات الحرب وتأثيرها على أجيال كاملة، على الأقل في مشكلة تسرّب ملايين الطلاب الحاليين من التعليم، فالمتسربون والمتسربات ومن لم تتح لهم فرصة إكمال تعليمهم ربما يفوق عددهم نصف الشعب السوري، حيث إن سورية تصنّف من الدول الفتية، ويجب وضع خطط طوارئ سريعة لتجنب كارثة قد تكون أول تحدٍّ يواجه استقرار الدولة الجديدة، فعدد الأطفال خارج المؤسسة التعليمية كارثة إنسانية، ويجب أن تكون هناك أولوية لفتح حوارات موسعة حول هذه القضية، فهي لا تقل أهمية عن نقاش الدستور والقانون، ويتشارك فيها كل فئات المجتمع ونخبه السياسية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، للتوافق على مقترحات عملية قابلة للتطبيق تجنّب خسارة سورية لأجيال كاملة.
مركز حرمون
——————————–
قراءة نقدية لمشروع وثيقة التوافقات الوطنية/ شلال كدو
يحاول عدد كبير من الشخصيات والنخب السياسية والفكرية والثقافية السورية المعارضة، من مختلف المشارب والملل والمكونات والأطياف، التوصّل إلى وثيقة توافقات وطنية، بعد أن أطلق مركز حرمون للدراسات المعاصرة حوارًا وطنيًا بين هذه النخب، حول مختلف القضايا الوطنية المهمة، ولا سيما الخلافية منها، بهدف التوصّل إلى حلول أو توافقات عليها، والاعتماد على مخرجات هذا الحوار لصياغة وثيقة التوافقات الوطنية التي من المفترض أن تكون ذات أهمية كبيرة، من شأنها أن تساعد في بناء الدولة الوطنية الحديثة وضمان استمرارها، ومن غير المستبعد، في حال التوافق عليها من قبل هذا الطيف الواسع من النخب، أن تكون هذه الوثيقة أحدَ روافد كتابة الدستور السوري الجديد.
من هنا، نرى أن الحاجة تزداد إلى الاهتمام بالوثيقة، نظرًا لأهميتها، ولكونها تطرح حلولًا جذرية ورؤى مستقبلية متوازنة، من قبل النخب المشار إليها، لمجمل القضايا العالقة والمزمنة في البلاد، فضلًا عن أننا نجد بين ثناياها أهم الأسس والمبادئ التي ستقوم عليها سورية الجديدة، مثل شكل الدولة الأنسب، ونظام الحكم فيها، وحاجتها إلى القواعد الدستورية المحصّنة أو المواد فوق الدستورية، التي تحصن التفاهمات والتوافقات الوطنية الكبرى وتحميها من التغيير أو الإلغاء، من قبل هذا الطرف أو ذاك، فضلًا عن معالجة الأزمتين القومية والطائفية، وترسيخ المواطنة المتساوية وعلمانية الدولية وسيادة القانون وغيرها..
ومن خلال إلقاء نظرة، ولو كانت بسيطة وغير عميقة، على الوثيقة؛ نجد أنها تتناقض بعض الشيء مع العنوان الذي وسمت نفسها به (وثيقة التوافقات الوطنية)، وكذلك مع الواقع الموضوعي لسورية، حيث يغلب عليها رأي الأكثرية في أكثر من مكان، غير آبهة بالتنوع الاثني والثقافي والحضاري والبشري في البلاد، الأمر الذي يتنافي مع مبدأ التوافق ومع المبادئ الوطنية أو المواطنة المتساوية للسوريين، بغض النظر عن عرقهم ودينهم ولونهم وطائفتهم، وبما أنها ما زالت مسوّدة خاضعة للنقاش والتحليل والتعديل، فلا ضير من أن نتحلى بشيء من الجرأة في مناقشة بعض الأفكار والآراء الواردة فيها، بهدف إخراجها إلى النور بحلة زاهية أنيقة تليق بالسوريين جميعًا.
في الفقرة (ث)، من وثيقة الأسس والمبادئ، بندٌ يقول: “يعتز الشعب السوري بتراثه الحضاري على تنوعه، وبانتمائه إلى الحضارتين العربية والإسلامية، ويسعى لتوطيد علاقة صداقة وتعاون وثيقة ومستقرة ومتوازنة مع الدول العربية”. انتهى الاقتباس.
إن هذا البند يُخفي في طياته الانحياز إلى أفكار قومية ودينية بعينها، ويمجد العروبة والإسلام، كما يختزل تفضيل عنصر على آخر، بسبب الدين والعرق، لأن عموم الشعب السوري لا ينتمي إلى هاتين الحضارتين العظيمتين فقط، حيث إن هنالك ملايين السوريين ينتمون إلى حضارات أخرى عريقة جدًا، يمتد جذورها في التاريخ إلى ما قبل آلاف السنين، كالحضارة الآشورية والآرامية والكردية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مفردات التراث والحضارة الكردية ما زالت حاضرة ومستمرة في سورية بوضوح شديد، ويراها الجميع دون استثناء، حيث ما زالت الطبيعة السورية الخلابة في معظم أنحاء البلاد تحتضن احتفالات ملايين الكرد السوريين، في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام، بأعياد النوروز، منذ أكثر من ستة وعشرين قرنًا من الزمن، إذ يمارس خلال هذا اليوم الأغر ملايين السوريين المحتفلين طقوسهم الحضارية والفلكلورية، التي تعكس قيم وعادات وتقاليد الكرد الذين ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الأوائل.
أما الحضارة الكلدو آشورية، فما زالت تمارَس في سورية من قبل أبناء شعبنا الكلدو آشوري وغيرهم من المكونات السورية أيضًا، وبصمات هذه الحضارة ما زالت بادية للعيان في أنحاء سورية، وهي ليست غائبة عن شبر من أراضيها وأراضي المنطقة برمتها، ومن غير المنصف أن نسلخ سورية عن الحضارة الكلدو آشورية المتناثرة في معظم أنحائها، وإن محاولة إبعاد السوريين عن حضاراتهم المتنوّعة، وصهرهم في بوتقة حضارة واحدة لا تمت إلى الواقع والحقيقة بشيء، هي ضرب من ضروب التعصّب لثقافة واحدة، لا تمثل الطيف الحضاري والثقافي السوري المتنوع، ولا يسهم ذلك في الوصول إلى وثيقة توافق وطني بين النخب السورية.
إن محاولة إلغاء حضارة الآخرين وثقافاتهم، والتغاضي عنها وعدم ذكرها وطمسها، تُفقد سورية عناصر ثرائها وتنوعها وغناها وقوتها، وتزج بها في أتون صراعات ثقافية وحضارية جانبية لا طائل منها ولا حاجة للسوريين إليها، وفي هذا المضمار من المفترض أن تتبع الأغلبية (المكون الأكبر) أسلوبًا آخر مغايرًا لهذا النمط من التعامل، مع المختلفين ثقافيًّا واثنيًّا، وأن تضطلع هذه الأغلبية بدور الأخ الأكبر، وتعمل على طمأنة الأقليات العددية على تاريخها وحقوقها ودورها وثقافاتها وحضارتها.
وفي البند نفسه، نرى أن مسودة الوثيقة تذكر أن الدولة (سورية المستقبل) سوف تقيم علاقات وطيدة مع الدول العربية، من دون ذكر طبيعة أنظمة حكمها وممارساتها ومصالح السوريين معها، وبذلك يبدو أن المعيار الرئيسي لإقامة علاقات وطيدة ومستقرة ومتوازنة مع الدول، هو المعيار القومي، الذي يتنافى مع أبسط قواعد البراغماتية السياسية التي تنتهجها مختلف دول العالم في العصر الراهن، وتضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات القومية والدينية والطائفية والأيديولوجية. وفي هذا المضمار، نرى أن إدراج هذه الفكرة، في الدستور السوري الدائم، من شأنه تكبيل البلاد بالأيديولوجية القومية، التي قد تتخذ العرقية معيارًا رئيسيًا لعلاقاتها الدولية.
إن بعض الأفكار آنفة الذكر الواردة في مسودة الوثيقة تشجّع إلى حد ما الأيديولوجيات العابرة للحدود الوطنية السورية، التي تصرف نظر السوريين عن قضاياهم الوطنية الملحّة، صوب شعارات غير واقعية، مثل حلم توحيد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، أو إعادة تشكيل الدولة الإسلامية الكبرى، وسيقابلها أيديولوجيات أخرى، كتلك التي تدعو إلى تحرير وتوحيد أجزاء كردستان الأربعة، أو إدخال العالم برمته إلى المنظومة الاشتراكية، لذا فإن أي إشارة في الوثيقة، ولو كانت غير مباشرة، إلى رهانات طوباوية خاسرة عفى عليها الزمن، لا يخدم قضية السوريين البتة، بقدر ما يعمّق الهوة بينهم، ويعني أنها تمنح نوعًا من الشرعية لجزء من هذه الأيديولوجيات، التي ستقابلها أخرى مشابهة لها، إن لم تكن أكثر انغلاقًا أو تطرفًا منها.
لذا، فإن من الأنسب أن تنأى الوثيقة بنفسها عن الصبغة الدينية والقومية، وأن تخرج إلى الفضاء الوطني الأوسع والأرحب والأشمل، لتمثل أبناء سورية كافة على مختلف انتماءاتهم وأديانهم وأعراقهم وطوائفهم، كون سورية بلد الأقوام والشعوب والحضارات، وليس من الحكمة تجريدها من هذه الميزات التي تمنحها القوة والمنعة والمتانة، وبالتالي، لا ضير -بتصوّري- أن يكون هذا البند من الوثيقة الذي نحن بصدده على الشكل التالي: (إن الشعب السوري يعتز بتراثه الحضاري، على تنوّعه، وبانتمائه إلى عدد من حضارات المنطقة، كالحضارة العربية والإسلامية والكردية والسريانية، ويسعى لتوطيد علاقة تعاون وصداقة ثابتة ومستقرة مع مختلف الدول العربية والإقليمية والعالمية، على قاعدة المصالح المتبادلة).
أما الفقرة (ز)، من وثيقة الأسس والمبادئ، فهي تتحدث عن شكل الدولة الأنسب لسورية الحديثة، وتحدده “باللامركزية الإدارية الموسعة” التي توفر للبلديات والمجالس صلاحيات موسعة، يحددها دستور ديمقراطي، وتزعم الوثيقة أن هذه الصيغة توفر أعلى مستوى ممكن من ممارسة الديمقراطية، كما تدعي بأنها الشكل الذي يستجيب لتطلعات السوريين جميعًا، ويراعي تنوّعهم ويحترم رغباتهم وثقافاتهم، ويعزز انتماءهم الوطني، وتضيف بأنها الضامن لمستوى أفضل من التنمية السياسية.
إن اللامركزية الإدارية معمولٌ بها في كثير من الدول المركزية والاتحادية أيضًا، وكذلك في داخل الأقاليم الفيدرالية والكونفدرالية نفسها، لكنها ليست الأنسب لسورية في هذه المرحلة، لأنها كنظام إداري لا تشمل سوى البلديات، ولا تتعداها إلى المستويات الأخرى من مؤسسات الحكم في البلاد، مثل الرئاسة والبرلمان والحكومة والجيش وقوى الأمن الداخلي وغيرها، خاصة حينما يتم تجريدها من كلمة “السياسية”، ليحل محلها “الإدارية الموسعة”، في مسعى حثيث للالتفاف عليها وتفريغها من محتواها الحقيقي، مما يفتح الطريق أمام الإبقاء على نظام مركزي يُشدّد قبضته على كل مفاصل الحكم في أنحاء البلاد، عدا البلديات التي تقدم الخدمات اليومية.
وفي هذا السياق، قد يتبادر إلى الأذهان تساؤل مشروع حول ما ورد في الوثيقة، بأن اللامركزية الإدارية الموسعة توفر أعلى مستوى ممكن من ممارسة الديمقراطية، وكأنه هنالك آلية ميكانيكية تؤدي إلى ارتفاع منسوب الديمقراطية فور تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، في حين لا يوجد أي ترابط منطقي بين اللامركزية الإدارية وممارسة مستوى الديمقراطية، والتساؤل هو: كيف للبلديات التي تُشرف على تقديم الخدمات اليومية للناس، من ماء وخبز وطاقة، أن تُهيّئَ البلاد لممارسة أقصى درجات الديمقراطية والحفاظ عليها بشكل مستدام؟! في حين نجد أن هنالك دولًا استبدادية شمولية بعيدة عن الديمقراطية، لكنها تعتمد اللامركزية الإدارية.
ويرد أيضًا في الوثيقة ما يسترعي الانتباه مثل: “تستجيب اللامركزية الإدارية الموسعة لتطلعات السوريين جميعًا، وتراعي تنوعهم وتحترم رغباتهم وثقافاتهم وتعزز انتمائهم الوطني”. انتهى الاقتباس. يلاحظ القارئ هنا نوعًا من التعصّب لصيغة اللامركزية الإدارية الموسعة، وكذلك يلاحظ تلميحًا إلى وجود إجماع حول هذه الفكرة، في حين يقول كثيرٌ من النخب السورية، ولا سيما من المكونات، بأن هنالك عدم رضى عن هذه الصيغة التي من شأنها أن تُؤدي إلى إجهاض ما يرمي إليه معظم الشعب السوري، الذي خرج في ثورة عظيمة من أجل تغيير جذري في النظام السياسي المركزي للبلد، والإتيان بنظام لامركزي سياسي، يمنح السوريين حقوقهم وحرياتهم في سائر المجالات.
أما الحديث عن مراعاة تنوع السوريين الاثني والديني والثقافي وغيره، فلا أظنه يمرّ عبر صيغة اللامركزية الإدارية البتة، كون صلاحياتها في عموم أنحاء العالم لا تتعدى تقديم الخدمات اليومية وإقامة مشاريع تنمية عمرانية وبنى تحتية وتنمية، بشكل متساو بين الوحدات الإدارية في البلاد، لذلك فإن مراعاة التنوع الثقافي والاثني والديني للسوريين يمرّ عبر نظام ديمقراطي لا مركزي أو اتحادي، يمنح صلاحيات سياسية وثقافية واجتماعية وقانونية دستورية، للكيانات الداخلية المرتبطة بالمركز وللوحدات الإدارية أو المحافظات، من هنا، نقول إن سورية الجديدة لا تحتاج إلى تجميل صورة الإدارة المحلية المعمول بها منذ عشرات السنين، بقدر ما تحتاج إلى صيغ أو أشكال أرقى لشكل للدولة.
وفيما يتعلق بتعزيز الانتماء الوطني، أو المواطنة المتساوية، فهذا الأمر بدوره مرتبط بالمركز بشكل وثيق، ولا تستطيع البلديات ولا مجالسها المحلية تعزيز الانتماء الوطني للمكونات والأفراد، لأن تعزيز الانتماء الوطني يحتاج إلى قرارات وطنية وسياسية، ستكون بيد المركز حصرًا، في حال تطبيق نموذج اللامركزية الإدارية الموسعة التي تمنح السلطات المركزية الصلاحيات السياسية والوطنية.
أما الفقرة (ط) من وثيقة الأسس والمبادئ التي تربط حل القضية الكردية في سورية باللامركزية الإدارية الموسعة، فقد أثر سلبًا في الديباجة المتوازنة والهادئة والمتصالحة لهذه الفقرة، وأفرغها من محتواها العقلاني والموضوعي الهادئ، لأن الربط الآلي أو الميكانيكي في ختام الفقرة، بين قضايا الشعوب وحقوقها بصيغة اللامركزية الإدارية الموسعة، لا ينسجم مع حجم هذه القضايا وأبعادها الداخلية والإقليمية والدولية، كما أن محاولة تسويق هذا الصيغة، وكأنها بمثابة العصا السحرية والبلسم الشافي الذي من شأنه أن يحل كل القضايا العالقة في البلاد، أمرٌ غير واقعي، ولا يرضي الرأي العام السوري.
إن وضع الحلول المستدامة لمشاكل البلاد العالقة والمزمنة يستوجب الإقرار باللامركزية (الإدارية والسياسية والثقافية والاجتماعية)، ابتداءً من أعلى الهرم في السلطة الذي يمتلك الصلاحيات باتخاذ القرارات المصيرية الكبرى، إلى أدنى مؤسسة حاكمة في البلاد، وفي هذا المضمار، نجد أنّ تنصيب العداء غير المبرر من قبل بعض النخب السورية، لصيغة الاتحادية (بغض النظر عن التسمية أو المصطلح) كنظام حكم لسورية المقبلة، والقول بأنها ستؤدي إلى تجزئة الأراضي السورية في نهاية المطاف، ليس إلا ضربًا من الخيال، يروج له كثيرون، ولا يوجد تجارب عملية عبر التاريخ تؤكد صحة هذه الهواجس.
فالدول التي فيها مئات الفيدراليات والكيانات الاتحادية ذات الصلاحيات الواسعة حافظت على وحدة أراضيها منذ عشرات السنين، إن لم نقل المئات من السنين، الهند مثالًا. أما الدول التي تعرضت وتتعرض للتقسيم، فهي الدول ذات الأنظمة المركزية الاستبدادية، والأمثلة كثيرة جدًا في هذا المجال، حيث هنالك دول عربية شديدة المركزية قُسّمت وكذلك الحال في دول أوروبية. وإن الأحداث والمعطيات تشيران إلى أن دولًا عربية عديدة تتجه نحو النظام الاتحادي، لحلّ أزماتها المزمنة درءًا للتقسيم، كالسودان وليبيا واليمن ولبنان، ومن غير المستبعد أن ينطبق الأمر ذاته على سورية، في نهاية المطاف.
أما القول بأنّ الدول الاتحادية في عموم أنحاء العالم هي أصلًا اتحادات بين دول مستقلة أو شبه مستقلة، أو بين إمارات كانت بالأصل منفصلة، فهو كلمة حقٍّ يراد به باطل، أو هو في أحسن الأحوال يأتي في سياق الخوف والهلع غير المبرر من التقسيم، بالرغم من عدم سعي أيّ طيف سياسي أو اثني أو ديني أو طائفي إلى التقسيم، إذ يعتبر الجميع المساس بوحدة الاراضي السورية خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وإذا سلّمنا جدلًا بهذا الأمر، فإن سورية الحالية مقسّمة ومجزأة، تحكمها أربع إدارات أو حكومات في حالة حرب فيما بينها، وبالتالي فإن من شأن صيغة الاتحادية في سورية أن توحد المقسّم أو المجزّأ، وليس العكس.
عمومًا، تعتبر الوثيقة بادرة وطنية قيّمة وفريدة من نوعها لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، ويستحق الجهد الذي بذله ويبذله الأصدقاء والصديقات في المركز المذكور الثناءَ والتقدير، ومن غير المستبعد أن تحقق هذه الجهود توافقات واسعة حول مجمل القضايا الوطنية الخلافية، بما يُرضي مختلف مكونات شعبنا، خاصة أنها ما زالت خاضعة للنقاش من قبل أوسع طيف نخبوي سوري، بهدف الخروج بتوافق شبه تام على مجمل القضايا الملحّة التي لا بدّ أن يتفق السوريون عليها، مثل الشكل الأنسب للدولة ونظام حكمها وعلمانيتها وانتمائها الحضاري والثقافي.
وفي الختام، رغم ملاحظاتنا على الوثيقة في بعض بنودها الجوهرية، فإنّ الفقرات التي لم نتطرق إلى مناقشتها، وهي تشكّل الجزءَ الأكبر من الوثيقة، تُناسب سورية الجديدة، مثل فكرة المواد المحصّنة للدستور أو المواد فوق الدستورية، وكذلك فصل السلطات وعلمانية الدولة، إضافة إلى سيادة القانون والحقوق والحريات في سورية الجديدة واستقلال القضاء ونظام الحكم ومعالجة الأزمات المزمنة والعدالة الانتقالية والمواطنة المتساوية، فضلًا عن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والتربية والتعليم وغيرها، ومعظمها قضايا غير خلافية، وربما يتم التوافق عليها من دون عناء يُذكر.
مركز حرمون
——————————–
سؤال الهوية بين “مشروع وثيقة تفاهمات وطنية” واتجاهات السوريين نحوها/ ريمون المعلولي
مقدمة:
تهدف هذه الورقة إلى تناول مادة الهوية لدى السوريين، من خلال مصدرَين: الأول وثيقة أصدرها فريق الحوار العامل في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، بعنوان “مشروع وثيقة توافقات وطنية”[1]، وهي نتاج جلسات حوارية دُعي إليها مفكرون وسياسيون سوريون أنتجوا تلك الوثيقة. والثاني نتاج مسح ميداني، هدف إلى تعرّف اتجاهات السوريين إزاء عدد من العبارات المتعلقة بسؤال الهوية.
إنّ سؤال الهوية مهمّ للإنسان على الدوام، وتزداد أهميته بالنسبة إلى السوريين، بعدما تعرّض له نسيج الجماعات السورية الاثنية والمذهبية، والعلاقات التي تربط بينها، من تهتّك نتيجة الأحداث المأساوية التي عاشها السوريون خلال العقد المنصرم، فضلًا عن دور التاريخ والجغرافيا في تعميق التباسات الهوية، على الصعيد الذهني والعاطفي والواقعي السياسي[2].
ولا شك في أن التنويعات الاثنية والدينية التي يتميز بها السوريون كانت بمثابة الأرضية الموضوعية، لقيام النظام الحاكم باستثمارها لمصلحته، من خلال اتباعه لسياسة (فرّق تسُد)، في مقابل تأكيده على الانتماء القومي العروبي للسوريين، ما أدى إلى إجهاض أي فرصة لنمو الوطنية السورية الجامعة.
والهوية على المستوى الشخصي/ الفردي والجمعي مفهوم دينامي، وهي تُولد وتنمو في سياقات معقدة من الخبرات والعلاقات التي يعيشها الفرد ويقيمها مع غيره من أفراد الجماعة/ الجماعات التي ينتمي إليها، ومع المحيط/ الموئل – الوطن، حيث يستمدّ منه مقومات حياته. وتختلف شدة عاطفة الانتماء وطبيعتها، بحسب طبيعة الخبرات، حيث تترافق الخبرات الإيجابية مع مشاعر العزّة والفخر بموضوع الانتماء، على خلاف ما ينتج عن الخبرات السلبية.
والهوية باعتبارها عاطفة انتماء وولاء، وإن كانت ذات طبيعة نفسية، فهي مفهوم دينامي ومركب يتضمن أبعادًا متعددة، وهي من جهة أخرى، عاطفة مكتسبة غير فطرية أو موروثة، تُولد وتنمو وتكبر لدى الأفراد، وقد تضعف وتموت.
أولًا- سؤال الهوية في “مشروع وثيقة تفاهمات وطنية”:
تناول مشروع الوثيقة مفهوم الهوية، من دون منحها عنوانًا منفردًا، بل كانت حاضرة من خلال العديد من التعبيرات المتنوعة المبثوثة في مضامين العديد من محاورها. وأقتبس من المضمون الذي ورد تحت عنوان “وثيقة الأسس والمبادئ”، بعض العبارات الموضحة للهوية التي تبناها مشروع الوثيقة المذكورة:
– التأكيد على أنّ “الشعب هو صاحب السيادة، وهو المصدر الأول للشرعية”، و “أن الشعب السوري يعتز بتنوعه في إطار وحدته الوطنية”، وبتراثه الحضاري، وانتمائه إلى الحضارتين العربية والإسلامية.
– التأكيد بوضوح على تبني “الهوية الوطنية للدولة”، وعلى “انتماء الفرد للهوية الوطنية”، و هدف “بناء الهوية الوطنية المشتركة بين السوريين”.
– التأكيد على منع تشكيل أحزاب على أسس دينية أو مذهبية، وتبنّي “العلمانية كخيار ضروري لإنقاذ سورية ولبقائها موحدة”، والتركيز على “الهوية الوطنية”، وانتهاج مبدأ “الحياد تجاه كل الأديان والمذاهب”.
– دعت الوثيقة “إلى ضرورة النظر إلى القضية الكردية باعتبارها جزءًا من القضية الوطنية والديمقراطية السورية”، و إلى “تبني قيم المواطنة المتساوية”.
إذًا، تبنّى مشروع وثيقة تفاهمات وطنية الهوية الوطنية السورية، وحدد موقفه من جميع المعيقات التي تحول دون وجودها وترسيخها، ودعا إلى تحصينها بمفاهيم المواطنة المتساوية وبالعلمانية، واعتبار أن القضية الاثنية هي قضية وطنية، وحلّها يكون عبر الدولة الحديثة.
ثانيًا- هوية السوريين كما أفاد بها مسح الاتجاهات
1- انطلق العمل على قياس اتجاهات عيّنة من السوريين نحو الهوية، من السؤال الرئيس الآتي: ما اتجاهات السوريين نحو قيمة “الهوية”؟ وقد تفرّع عنه عدد من الأسئلة الصغرى:
– كيف يُعرِّف السوري نفسَه اليوم؟ هل بدلالة الهوية الدينية، أم القومية أو الوطنية؟ وأيّهما أغلب؟ وهل لديه أكثر من انتماء وهوية، في آن معًا؟ هل لديه هوية أولى/ أساسية؟ أم أنه ما زال مشتتًا بين عدد منها؟
– هل لمتغيرات العمر والوضع التعليمي والتركيب الجندري/ الجنساني لأفراد العينة، أثرٌ في التوجه الهوياتي للفرد؟
2- تكمن أهمية تعرف اتجاهات السوريين نحو الهوية في الوقوف على مدى التوافق و/أو التشتت الهوياتي الذي يجتمع عليه السوريون. ما يسمح لأصحاب الرأي من سياسيين ومفكرين ببناء استراتيجيات توعوية/ تربوية، وتوجيهها إلى السوريين.
3- المنهج: اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من النوع المسحي، واستخدم الاستبانة الخماسية لقياس الاتجاهات.
4- المجتمع والعينة: العينة عَرَضية، موزعة بين الفئات العمرية والجنس والمستويات التعليمية، فضلًا عن توزعها على مناطق جغرافية متعددة. وبلغ إجمالي عدد الاستبانات المستردة (303) استبانة.
4- خصائص العينة:
أ- حسب العمر:
توزع العيّنة حسب الفئات العمرية
ب- حسب الجنس:
توزع العينة حسب الجنس
ج- حسب المستويات التعليمية:
توزع العينة حسب المستوى التعليمي
د- حسب مكان الإقامة الحالي:
توزع العينة حسب مكان الإقامة الحالي
5- نتائج الدراسة:
كيف توزعت ولاءات السوريين ومواقفهم من هوية الدولة؟
وضعت البنود في استبانة رقمية/ إلكترونية لقياس اتجاهات عينة من السوريين، وجمعت استجاباتهم نحوها، ثمتمّ تحليلها على المستوى الكلي أولًا، ثم على المستوى التفصيلي ارتباطًا بمتغيرات: العمر والجنس والمستوى التعليمي، وخضعت النتائج للتحليل الإحصائي والتفسير. فكانت النتائج:
ولائي لديني أهم من ولائي لسورية: أكثر من نصف حجم العينة (57%) أعلن تأييده (موافق بشدة وموافق) لفكرة أولوية الولاء للدين على الولاء لسورية، فيما رفضها (36%)، وامتنع (7%) عن التصريح باتجاههم.
اللافت أن (76%) من أفراد الفئة العمرية (20 > 35) سنة قدّموا الولاء الديني على الولاء الوطني (لسورية)، بينما انخفضت النسبة إلى (65 %) من أفراد الفئة (35 > 50) سنة، فيما انخفضت النسبة إلى(21%) عند الفئة (50> 65)، وإلى (11%) لدى الفئة العمرية الأعلى.
فالولاء للدين سابق على الولاء الوطني بوضوح، لدى أفراد الفئتين العمريتين الأصغر، على خلاف الفئتين الأكبر عمرًا. وكانت الإناث أكثر تمسكًا بأولوية الولاء للدين (85%)، مقابل (46%) لدى الذكور.
وعند النظر في استجابات العيّنة على أساس المستوى التعليمي، كانت النسب المفضلة للانتماء الديني مرتفعة لدى عينة حملة الابتدائية والإعدادية (87.5%)، وانخفضت إلى نحو (70%) لدى حملة الشهادة الثانوية، وإلى (62%) لدى الجامعيين والجامعيات، فيما تقلصت إلى (23%) لدى حملة الشهادات العليا.
فالعلاقة عكسية بين التعليم وتفضيل الانتماء الديني على الوطني/ السوري، أي ترتفع نسب المؤيدين لفكرة أولوية الهوية الدينية على السورية، بين أوساط السوريين (العينة) الأقل تعليمًا.
انتماء السوريين للأمة العربية أولوية على جميع انتماءاتهم: (43.5%) كانت اتجاهاتهم إيجابية (موافق بقوة وموافق)، مقابل (43%) سجلوا اتجاهًا سلبيًا (رافض ورافض بشدة) لفكرة أولوية الانتماء العربي على جميع الانتماءات، مع ارتفاع نسبة غير المصرّحين عن اتجاهاتهم إلى (14%). هذا على المستوى الإجمالي.
وبحسب العمر، انقسمت العيّنة بين موافق وبشدة، ورافض وبشدة، إلى نسب متقاربة لدى جميع الفئات، حيث وافق نحو (43%) على أولوية الانتماء للأمة العربية لدى الفئة (20 > 35سنة)، و(45%) لدى الفئة العمرية (35 > 50)، و(39%) لدى الفئة (50 > 65)، و(46%) لدى الفئة العمرية المتقدمة (+65 سنة). إذن، لا توجد فروق جوهرية بين الفئات العمرية على صعيد أولوية الانتماء للامة العربية.
وبحسب الجنس، سجلت الإناث نسبة تأييد أعلى (51%) لأولوية الانتماء العربي (القومي)، مقابل (30%) للذكور.
والملاحظ انخفاض نسب المؤيدين لأولوية الانتماء القومي مع ارتفاع المستوى التعليمي؛ حيث انخفضت من (62%) لدى حملة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى (42%) لدى الجامعيين، وإلى (38%) لدى أصحاب الشهادات العليا (أعلى من المستوى الجامعي)، وهذا يعني أن العلاقة عكسية بين الولاء للهوية القومية والمستوى التعليمي للفرد.
يجب نزع صفة “العربية” عن اسم سورية، لتصبح “الجمهورية السورية”: وافق (38%) على نزع صفة العربية عن اسم سورية، مقابل ذلك رفضها (45%)، ولم يعلن رأيًا (16.5%). أي ما زالت الغلبة واضحة “للعربية السورية”، على مستوى إجمالي العيّنة.
وتفصيليًا، سجّلت عينات السوريين الأكبر سنًا موافقات أعلى لفكرة تجريد اسم سورية من الانتماء العربي، (57%) للفئة (+65 سنة)، و(54%) للفئة (50> 65)، وانخفضت إلى (37%) للفئة (35> 50)، وتقلصت إلى (29%) لدى فئة الشباب (20> 35) سنة.
وسجلت الإناث نسبةرفض أعلى لفكرة استبعاد الهوية العربية عن اسم سورية (64%)، مقابل (38%) للذكور.
وأكثر الفئات التعليمية تمسكًا بالهوية العربية لسورية هي من المستوى التعليمي (ابتدائية واعدادية)، حيث رفض فكرة نزع العربية عن اسم سورية (أكثر من (87%)، ثم توالى انخفاض النسبة لدى الفئات التعليمية الأعلى، ليبلغ أدناها (25%) لدى الشريحة الأعلى تعليمًا، ما يسمح باستنتاج وجود علاقة طردية بين المستوى التعليمي والاتجاهات الإيجابية (الموافقة) نحو نزع صفة العربية عن اسم سورية.
من حق المكونات الاثنية السورية السعي لنيل حقوقها بما في ذلك حق الانفصال:
من هم الموافقون على حق تقرير المصير للاثنيات حتى بلوغ الانفصال عن سورية؟ (56%) من إجمالي العينة رفضوا فكرة منح المكونات السورية الاثنية حق الانفصال، مقابل ذلك أيّد الفكرة (28%)، وتردد في موقفه (16%) من العينة.
وعلى صعيد العينات الفرعية، لم تلق فكرة حق المكونات الاثنية السورية بالانفصال عن سورية ترحيبًا من جانب غالبية العينات العمرية، بل إنهم رفضوها، ولا سيما الفئة الأكبر عمرًا (50 > 65) التي سجلت أعلى نسب الرفض ( 75%) منهم، ثم الفئة (35 > 50 سنة) بنسبة (64%)، في حين رفضها من فئة الشباب (20 > 35) (45%). واللافت امتناع (43%) من الإناث عن إعلان اتجاههن (لا رأي)، فيما أعلن خُمسهن الموافقة (20%) على الفكرة، مقابل (28%) من الذكور كانوا موافقين.
وقد ارتفعت نسبة الممتنعين عن إعلان اتجاههم، لدى حاملي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى (38%)، مقابل تأييدها من قبل (37%) منهم. واللافت انخفاض نسب الموافقة على فكرة حقوق الاثنيات حتى الانفصال إلى (24%) لدى عينة الجامعيين، و(36%) لدى شريحة الشهادات العليا.
إن قضية حقوق الاثنيات بشكل عام وحقهم بالانفصال مسألة إشكالية، وقد بدا ذلك من خلال ارتفاع نسب المترددين (لا أدري) بين مختلف العينات.
الولاء الأول لسورية ضمان لوحدة السوريين بغض النظر عن ولاءاتهم الأخرى: رحّب (78%) من العينة الإجمالية بالفكرة، وهذه أعلى نسب الموافقة المسجلة على مستوى جميع البنود،مقابل ذلك رفضَها (14%).
ارتفعت نسبة المؤيدين لفكرة الولاء لسورية ضمانة وحدة السوريين طردًا مع ارتفاع العمر لأفراد العينة، فقد أيّدها (66%) من فئة الشباب (30> 35)، وبلغت (93%) لدى الشريحة العمرية (+65 سنة)، وفيما سجل الذكور نسبة موافقة مرتفعة (83%)، أيدها (61%) من الإناث.
واللافت ارتفاع نسبة المترددين في الإجابة عن الفكرة من ذوي المستوى التعليمي الأدنى إلى (50%)، وأيّدها (50%) منهم. ما عدا ذلك فقد رحّب بها غالبية الأفراد من المستويات التعليمية الأعلى (97%) و(76%) و(83%) تباعًا، ما يعني أن العلاقة بين التمسك بفكرة الوطنية الموحدة للسوريين والمستويات التعليمية العليا قوية.
أرفض فصل الدين عن الدولة : أكثر من(50%) من إجمالي العينة رغبوا في الارتباط بين الدولة والهوية الدينية، مقابل ( 40%) قالوا بفصلهما.
وعلى المستوى التفصيلي: فقد رفض الفصل (62%) من الفئة الشابة (20>35)، و(55%) من الفئة العمرية الأعلى (35> 50)، فيما تقلصت نسبة الرفض إلى (28%)، و(21%) لدى عينتي العمر (50> 65) (+65)؛ ما يعني أن الشرائح العمرية الأعلى أكثر قبولًا لفكرة الفصل بين الدين والدولة.
واللافت أنّ الإناث أشد تمسكًا بهوية الدولة الدينية (68%) مقابل (44%) للذكور. وأن جميع أفراد العينة من ذوي التحصيل التعليمي (الابتدائي والاعدادي) (100%) رفضوا الفصل بين الدولة والدين، ثم انخفضت نسبة الرافضين لفكرة الفصل، لدى الشريحة التعليمية الأعلى (الثانوية)، إلى (70%)، وإلى (49%) و(40%) لدى ذوي التعليم الأعلى (الجامعية والعليا) على التوالي. ما يعني أن الفئات التعليمية الأعلى أكثر تأييدًا لفصل الدولة عن الدين.
وجود نظام ديمقراطي – علماني في سورية هو حل ملائم لجميع المكونات السورية: أكثر من نصف المستجيبين (51%) أيدوا الفكرة، مقابل ذلك رفضها (38%) من إجمالي العينة، والباقون لا رأي لهم.
وكان الشباب أكثر تحفظًا من باقي الفئات العمرية نحو النظام العلماني الديمقراطي، حيث أعلن (52%) من أفراد الفئة العمرية الشابة (20>35) سنة رفضهم الفكرة. على خلاف الفئات العمرية الأعلى، حيث وافق عليها (53%) من الفئة العمرية (35> 50)، و(80%) من الفئة (50> 65)، و (82%) من الفئة العمرية الأعلى (+65). أي إن فكرة وجود نظام ديمقراطي- علماني في سورية حازت موافقة واسعة بين الفئات العمرية المتقدمة، على خلاف الشباب، وهذه نتيجة لافتة للنظر. وكان الذكور أكثر تقبلًا لفكرة الدولة الديمقراطية – العلمانية، حيث وافق عليها (61%) منهم، في مقابل انخفاض المؤيدات لها بين الإناث إلى (26%) فقط!
ومع تحسن المستويات التعليمية لأفراد العينة، ترتفع نسب التأييد للفكرة، وتتقلص نسب الرفض لها؛ فقد ارتفعت نسبة الرافضين إلى (75%) بين ذوي التحصيل الأدنى، في مقابل (43%) –(37%) –(25%) لدى حملة الشهادات الأعلى، بدءًا من مستوى الثانوية، مرورًا بالشهادات العليا. فالعلاقة بين تأييد فكرة علمانية وديمقراطية الدولة والمستوى التعليمي طردية.
لا مانع من أن يكون الرئيس المقبل لسورية غير مسلم: نصف المستجيبين للمسح وافقوا على عدم التمسك بدين الرئيس. مقابل (41%) لم يوافقوا، وتحفظ (8%) هذا على المستوى الإجمالي.
وعلى مستوى العينات الفرعية، رفض هذه العبارة أكثر من نصف (56%) عينة الشباب من عمر (20>35) سنة، و(42%) من الفئة العمرية (35- >50)، ثم تقلّصت نسب الرفض لدى الفئتين العمريتين التاليتين إلى (21%) – (7%)، ما يعني أن الفئات العمرية الأكبر كانوا أكثر انفتاحًا على فكرة التخلي عن تحديد دين الرئيس.
واضح أن الذكور كانوا أكثر تقبلًا للفكرة، فقد أيّدها (61%) منهم، مقابل (19%) من الإناث. واللافت هنا أيضًا أن أشد الرافضين للفكرة كانوا من ذوي المستوى التعليمي الأقل، (75%) منهم مقابل تقلص النسبة إلى(39%) بين حملة الشهادة الثانوية، و(46%) من الجامعيين و(13%) من ذوي الشهادات العليا، حيث أيدها (85%) منهم. إذن تلقى فكرة عدم التمسك بدين الرئيس تأييدًا متصاعدًا، مع تحسّن المستوى التعليمي للسكان (العينة).
توزع الاتجاهات نحو موضوعات الهوية بحسب درجاتها
من الضروري الاتفاق على مرجعية دينية للدولة السورية مستقبلًا: وهنا عودة لفكرة الدين والدولة، ولكن كمرجعية ليس أكثر، وقد وافق عليها (50%) من إجمالي العينة، فيما رفضها (36 %) ولم يعلن (14%) منهم عن اتجاه صريح.
هذا وقد أعلن تأييده لفكرة المرجعية الدينية للدولة (62%) من الشباب (20>35) سنة، و (55%) من الفئة العمرية الأعلى (35> 50) سنة، فيما انخفضت نسبتهم إلى (29%)، ثم إلى (10%)، لدى الفئتين (50> 65) سنة و (+65) سنة على التوالي، هذا يعني ارتفاع نسبة رافضي المرجعية الدينية للدولة، مع التقدم بالعمر.
وكانت الإناث أشدّ تمسكًا بفكرة المرجعية الدينية، فقد وافقتها (80%) مقابل (40%) للذكور. وبحسب المستويات التعليمية، كان ذوو المستوى التعليمي الأقل (ابتدائي وإعدادي) أكثر تمسكًا بالمرجعية الدينية، وبلغت نسبتهم (50%)، وقريب منها (48%) سجلها ذوو الشهادة الثانوية، و(55%) لذوي الشهادة الجامعية. وفي المقابل، انخفضت نسبة المؤيدين للمرجعية الدينية إلى (31%)، لدى حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه). إذن تتضح العلاقة بين التمسك بفكرة المرجعية الدينية للدولة لدى الشباب والإناث وذوي المستويات التعليمية الأقل.
الخلاصة:
تباينت نسب التأييد والرفض للعبارات (القيم) التي جرى استطلاع الاتجاهات نحوها على المستوى الكلي للعينة، وكذا على مستوى العينات الفرعية التي تناولتها الدراسة.
عمومًا، تبين أن الاتجاهات، سواء كانت بالاتجاه السالب أو الموجب (موافقة – رفض)، تتغير تبعًا لمتغيرات العمر والجنس والتعليم.
ما يدعونا للتأكيد على الأمور التالية:
–صعوبة بلوغ تفاهمات سهلة حول هوية الدولة المنشودة بين السوريين، على اختلاف تنوعاتهم.
–تبدو اتجاهات العينات العمرية العليا، والذكور، والتعليمية الأعلى أكثر وضوحًا وانحيازًا/ تأييدًا للعديد من القيم التي طرحتها استبانة البحث: الهوية الوطنية السورية، العلمانية، على خلاف عينات الشباب والإناث وذوي المستويات التعليمية الأقل.
–الأمر الذي يتطلب توجيه عناية خاصة للفئات العمرية الصغيرة، وللإناث، وذوي المستويات التعليمية الأقل، بغية تعزيز القيم المنسجمة مع الحداثة، عبر برامج التعليم والتوعية بجميع أشكالها: النظامية وغير النظامية، ومن ضمنها برامج الإعلام التنموي، من دون إغفال أهمية التحولات الاقتصادية – الاجتماعية في إحداث التغيير المطلوب.
–ضرورة لفت الانتباه عند صياغة وثائق فكرية – سياسية إلى أهمية المتغيرات السكانية: العمر والتعليم ومكان الإقامة والجنس و… الخ، في التأثير في اتجاهات السكان وإمكانية تغييرها عبر برامج التنمية الشاملة.
[1] إصدار مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
[2] راجع:
– المعلولي: في الأصول التاريخية للوطنية السوربة. https://2u.pw/e7OOhdH
– حول الوطنية، كي لا نبقى في الوهم https://2u.pw/pyX3d20
مركز حرمون
——————————
=======================